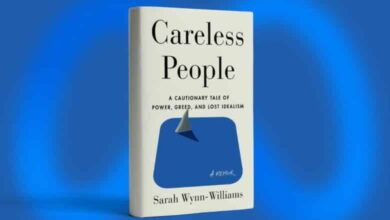المأساة السورية وليمة صحفية: كتاب “الأسد أو نحرق البلد”/ راتب شعبو
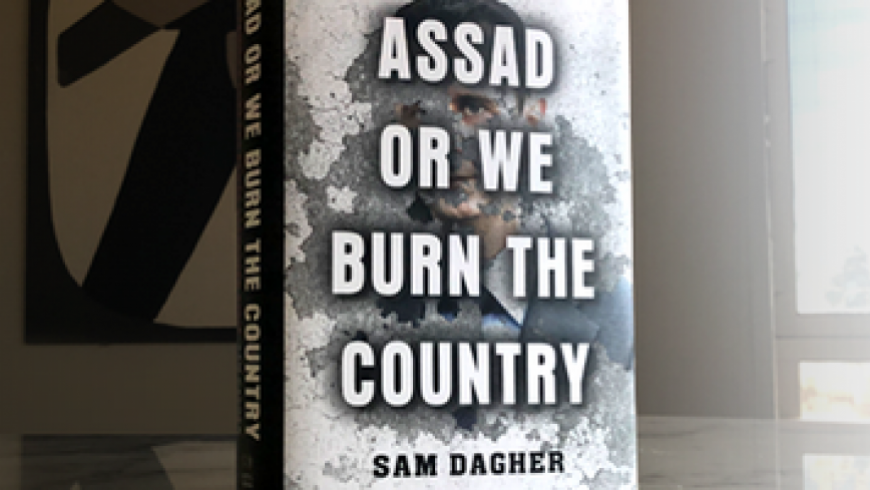
يختار الصحفي الامريكي سام داغر (ٍSam Dagher) عبارة (الأسد أو نحرق البلد) (Assad or we burn the country) عنواناً لكتابه عن مجريات الثورة السورية التي اندلعت في مطلع 2011، ويشرح العنوان الشديد الوضوح، بعنوان فرعي يقول: (كيف قادت شهوة السلطة لدى عائلة إلى تدمير سورية)، How one family’s lust for power destroyed Syria.
سام داغر صحفي أميريكي غطى أحداث الشرق الأوسط لمدة 15 عاماً لصالح وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. وقد غطت تقاريره حرب الاحتلال الأميريكي للعراق كما غطت الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي. وهو أحد المرشحين لنيل جائزة بولتزر عن كتابه الذي نتناوله هنا، والذي صدرت طبعته الأولى في أيار/مايو 2019.
بدأ داغر عمله الصحفي من دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 2012، وكان الصحفي الغربي الوحيد ذا الإقامة الدائمة في دمشق. قبل سبعة أشهر من مباشرته عمله الصحفي في دمشق، أي في شباط/فبراير 2012، كان صحفيان أميريكيان، هما ماري كولفين (Marie Calvin) وأنتوني شديد (Anthony Shadid)، قد قضيا أثناء قيامهما بمهامهما الصحفية داخل سورية، ولكن في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد. بعد حوالي سنة من بداية عمله في سورية، اعتقل داغر لفترة وجيزة في أحد أقبية المخابرات. كان حظه طيباً أنه خرج سليماً، فقد كان يمكن أن يخفوه في الأقبية أو أن يقوموا بقتله ونسب الفعل لإرهابيين آخرين، كما قال له أحد أصدقائه السوريين. صار داغر بعد ذلك عرضة للتهديد والوعيد، إلى أن طُرد من سورية في أواخر العام 2014، ووضعت “المخابرات” (يعرف داغر المخابرات بأنها “بوليس سري”، ثم يستخدم الكلمة العربية في كامل النص الانكليزي لغياب كلمة انكليزية تعطي المعنى والمحتوى النفسي المناسب) اسمه على القائمة السوداء. بعد ذلك فكر داغر بإنجاز كتابه هذا.
العبارة المستخدمة عنواناً للكتاب تكشف، بأربع كلمات، العمق المظلم لنظام الأسد في سورية “الأسد أو نحرق البلد”. تخطت هذه العبارة في غضون السنوات التسع الماضية، كونها صيحة “تشبيح” تهدف إلى التهديد والإرهاب، إلى كونها حقيقة عاشها ويعيشها السوريون حتى باتت العبارة تحرض في نفوسهم الشعور بمزيج من الإهانة العميقة والقهر وحتى الخجل.
كيف أمكن أن يحصل ما حصل؟ كيف يكون لكل هذا العنف الفاحش والعاري أن يجد له مكاناً في عصر الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والفضائيات؟ كيف لضمير العالم أن يمرر مثل هذه المأساة المستمرة؟ ما هي الوصفة السحرية التي تجعل العالم يرى في مجرم يقتل محكوميه على مدى تسع سنوات، شريكاً ممكناً وحاجة ضرورية؟ هل يكون العالم عاجزاً إلى الحد الذي يجعل المبعوث الأممي لحل الصراع الدائر في سورية ستيفان دي ميستورا (Staffan de Mistura) يقول: “لن يكون هناك سلام إن أردتم العدالة والمحاسبة، عليكم أن تختاروا بين السلام والمحاسبة”؟
الحكم العائلي “يعانق السحبا”
يحاول داغر الإجابة على السؤال الذي يثبته كعنوان فرعي للكتاب: “كيف قادت شهوة السلطة لدى عائلة إلى تدمير سورية”؟ من خلال ثلاثة محاور الأول هو البحث في نشوء الحكم العائلي في سورية وتكريس العلاقة المتبادلة بين السلطة العائلية وطائفة الرئيس. والثاني هو البحث في التركيبة الشخصية والنفسية للوريث بشار الذي انتقل بسبب موت أخيه باسل في مطلع 1994، من هامش العائلة إلى المركز، ما جعل عقدة الهامشية وإثبات الذات، فاعلة في تحديد خياراته كرئيس في لحظة تهديد حكمه. والثالث هو المجال السياسي العالمي المختل إلى حد أنه يقبل المرض (الاستبداد العصبوي) للخلاص من الأعراض (التطرف والإرهاب وانعدام الاستقرار).
يستعيد الكتاب تاريخ تشكل حكم الأسد والعلاقة الوطيدة التي ربطت بين حافظ الأسد ومصطفى طلاس على أنها أحد أسس قيام وصمود نظام الأسد. مصطفى من عائلة ريفية متواضعة ينتسب إلى الكلية الحربية بوصفها معبراً ممكناً إلى تحسين المكانة الاجتماعية وربما إلى السلطة والمجد، والحال مشابه بالنسبة لحافظ الأسد. في 1953، يكون الرجلان في عداد أول صف يُقبل في كلية القوى الجوية التي أسستها الدولة السورية الفتية شمال مدينة حلب. كان الحديث السياسي محظوراً داخل الكلية (ذلك قبل أن يصبح الجيش الوطني ذراعاً عسكرية للحزب الحاكم)، مع ذلك اكتشف الرجلان تقاربهما السياسي “البعثي” ونشأت بينهما علاقة قامت أولاً على التقارب السياسي ولكنها استمرت فيما بعد على أساس المصلحة المتبادلة التي تؤمنها السلطة. شخصيتان مختلفتان ولكنهما متكاملتان. استقرت العلاقة على ولاء وثقة مطلقة من جانب طلاس للأسد، مع إدراك الأول للمضمون الحقيقي للسلطة التي يمثلها الثاني. لم يكن طلاس مخدوعاً بأن الأسد يعمل على رفع البعث وتحقيق غاياته، بل كان يدرك جيداً أن الأسد يؤسس لحكم عائلة، وأن السلطة هي الغاية الأولى والأخيرة وكان ولاؤه يقوم على هذا الإدراك، ومن هنا منبع قوة العلاقة وفاعليتها وديمومتها.
يستعرض الكتاب العلاقة السياسية والسلطوية والشخصية بين الرجلين: عناية طلاس بعائلة الأسد حين سجن هذا في القاهرة عقب حركة الانفصال في سورية 1961، وتكفل طلاس بنقل عائلة الأسد مع عائلته إلى سورية عبر البحر. محاولة الانقلاب الفاشلة في 1962 ثم سجن الأسد وطلاس، بقاء الثاني في السجن وخروج الأول بعد أيام قليلة، ثم تسريح الأسد من الجيش وتحويله إلى وظيفة مدنية في اللاذقية، ثم ولادة الابن الثاني لمصطفى طلاس (مناف)، وهو لا يزال في السجن، بعد وقت قصير من ولادة الابن الذكر البكر لحافظ (باسل). سيصبح مناف قائداً للحرس الجمهوري، ولكنه سيفشل في تكرار علاقة طلاس/الأسد مع الأسد الوريث، فيما سيقضي باسل في حادث سير بعد أن كان جاهزاً لخلافة أبيه.
الولاء والثقة المطلقة التي أولاها مصطفى لحافظ جعلته يقدم، بتوجيه من الأخير، على محاكمة وقتل منافسين سياسيين مثل سليم حاطوم وبدر جمعة حال عودتهما إلى سورية عقب هزيمة 1967، وجعلته يعمل يداً بيد مع الأسد على عزل صلاح جديد عن طريق إبعاد الضباط الموالين له في الجيش. والأهم أن مصطفى كان جاهزاً للتوقيع على آلاف أحكام الإعدام الميدانية بحق من اعتبروا عناصر لحركة الأخوان المسلمين في سورية. المرة الوحيدة التي تعكر فيها قليلاً جو الود بين الرجلين كان فيما يخص موافقة حافظ على الميزانية العسكرية الهائلة التي طالب رفعت بتخصيصها لسرايا الدفاع، وذلك على خلاف رأي مصطفى الذي ذهب إلى موسكو لوقت قصير كنوع من التعبير عن الاحتجاج، ولكن في 1984 كان مصطفى جاهزاً للوقوف بحزم مع حافظ في وجه أخيه رفعت.
بعد موت الأسد الأب، كان طلاس يمثل الحضور القوي لحافظ في غيابه، حين قاد عملية التوريث. “كان على مصطفى الذي بلغ الثامنة والستين قبل شهر، أن ينفذ وصية حافظ: انقل السلطة التي عملنا لها طوال حياتنا إلى بشار. وكان حافظ قد أجل تقاعد مصطفى بمرسوم استثنائي واحتفظ به وزيرا للدفاع كي يرعى نقل السلطة لبشار .. فقد استدعى مصطفى كبار الضباط إلى مكتبه واقترح عليهم ترفيع بشار إلى مرتبة القائد العام للجيش: موافقتكم تعني أنكم ستحافظون جميعا على امتيازاتكم غير منقوصة. أرجو ممن يعترض أن يغادر الآن من هذا الباب. قال مصطفى مشيرا إلى باب خلفي كان قد وضع عليه جنوداً مزودين بأمر إطلاق النار وقتل كل من يخرج من الباب. لم يخرج أحد”.
وكان طلاس الأب قد نصح بشار: “إذا شئت أن تستمر في الحكم عليك أن تزرع الخوف في نفوس الآخرين”، هذه النصيحة التي لا شك أن بشار سمعها مراراً من أبيه، وأضاف عليها: “وعليك أن تقتل فيهم أي أمل في التغيير”.
أثر التكوين الشخصي لبشار
ما كان يمكن لمناف طلاس أن يكون لبشار كما كان مصطفى لحافظ. العلاقة مختلفة في نشأتها وفي طرفيها. مناف في الأصل صديق لباسل الأسد وليس لبشار الذي يصغره بعامين، والذي كان لظروف نشأته وطبيعته الشخصية دور مهم في طريقة معالجة الحدث الأول في درعا ثم في معالجة تداعيات ذلك الحدث.
يكرس الكاتب جزءاً من عمله للبحث في شخصية بشار الذي كان مُهمَلاً من الأب ومقموعاً من اخته البكر وأخيه الأكبر اللذان كانا في موقع التقدير الأعلى في العائلة. لذلك كان لدى بشار مشاكل شخصية عديدة مثل الانعزال والخجل وتقلب المزاج والعجز عن بناء الصداقات، “يكون صديقك في بداية السنة ثم يقطع علاقته بك في نهاية الفصل ويتظاهر أنه لا يعرفك”، يقول أحد زملائه في الصف، ويضيف: “لم يكن يميل إلى مساعدة أحد، أو تقاسم شيء مع أحد، حتى ولو قطعة من الشوكولا”.
الشعور القديم بالهامشية يدفع بشار، وقد أصبح رئيساً، إلى إثبات الذات على نحو مبالغ فيه. بالنسبة له فإن قوة حضور أبيه وأخيه البكر كانت وحشاً يتوجب عليه أن يقتله كي يثبت نفسه. “أريد أن ينسى العالم باسل وأبي – أنا أستطيع أن أحقق ذلك”، أسرّ مرة لمناف طلاس. وينقل فنان سوري كان على علاقة ببشار أن هذا الأخير كان ينفر من الذين يقولون له حين يلتقونه “رحم الله أباك”، فهو يرى في ذلك استمراراً للتهميش ولكسوف صورة الابن أمام صورة الأب. قد يكون في هذا تفسير للازدواجية التي يعرضها بشار بين الطيبة الظاهرة وإضمار الاحتقار للناس، كما بين الواجهة الحضارية والعمق الهمجي. كان يمكن لهذه الازدواجية أن لا تظهر لو لم يصل هذا الرجل إلى الموقع الأول في سلطة مبنية على العنف والتمييز.
يرصد الكاتب تغيرات في شخصية بشار بعد عودته إلى سورية إثر وفاة باسل ثم بدء إعداده لخلافة أبيه وبدء احتكاكه مع العسكر والمخابرات. من التغيرات وصوله إلى قناعة تتعارض مع الصورة الحضارية التي جرى الترويج لها في شخصيته، قناعة عبر عنها في وقت مبكر (1995) لأصدقائه الذين باتوا أكثر تلهفاً لمعرفة ما يدور في رأس “ولي العهد” من أفكار: “لا توجد طريقة أخرى لحكم مجتمعنا سوى بإبقاء الحذاء على رؤوس الناس”.
سيكون مناف طلاس المحور الأساسي في الكتاب، بوصفه جزءاً من القصر الذي انقسم إزاء الثورة بين أشداء وليّنين، بين بطشيين وتفاوضيين راحوا يتنافسون على كسب الأسد الذي كان ينوس بين الطرفين، كما كان يخال مناف قبل أن يكتشف أن الوريث في الأساس هو صاحب خيار الحسم الأمني العسكري، ولكنه كان يجيد التمويه والتواجد في الأرض الفاصلة بين المعسكرين أو حتى الظهور أقرب إلى التصالحيين. قبل هذا الاكتشاف كان مناف يرى أن بشار خاضع لتأثير المتشددين ضمن الدائرة الضيقة (أمثال ماهر الأسد وحافظ مخلوف) الذين أفسدوا أول مسعى تفاوضي قام به، بطلب من بشار، موفق القداح (رجل أعمال من أبناء درعا، وله مشاريع مشتركة مع رامي مخلوف ولكن له احترام وتقدير لدى الأهالي)، بين المعتصمين في الجامع العمري في درعا وبين النظام في 22 آذار 2011. فقد وافق المعتصمون، بعد ساعات من التفاوض، على مغادرة الجامع بشرط الإفراج الفوري عن كل المعتقلين منذ 18 آذار ومعرفة مصير المفقودين. وما أن اتجه قداح ومرافقوه لنقل الاتفاق إلى خلية الأزمة في الجانب الآخر من المدينة، حتى عم الظلام المدينة فجأة وقطعت خدمة الانترنت عنها، وعلا صوت الرصاص، ثم خرج نداء من الجامع عبر مكبرات الصوت: “يا أهالي درعا أنجدونا، إننا نتعرض للقتل”. جرح في تلك الليلة الكثير من المعتصمين وقتل ثمانية منهم على الأقل، بينهم طبيب جاء للنجدة في سيارة إسعاف.
كما أفسد المتشددون وساطة أخرى مع أهالي دوما قام بها مناف طلاس، أيضاً بطلب من بشار. فقد استقبل بشار، بعد وساطة مناف، وفداً من أهالي دوما وقدم لهم التعازي وأخبرهم أن كل من قتل سيعتبر شهيداً وسيعوض على عائلاتهم، كما سيعالج الجرحى على نفقة الحكومة وسيجري تحقيقاً فيما جرى ويعاقب المرتكبين. وقال إنه سيلتقيهم في غضون أسبوع، ولكن بدلاً من مقابلة بشار بعد أسبوع، وجد هؤلاء أنفسهم تحت التعذيب في أقبية المخابرات.
الازدواجية نفسها مارسها بشار مع أنصاره قبل الثورة، فقد عين مثلاً محمود سلامة، وهو شخصية لها بعض الاستقلالية، رئيساً لتحرير جريدة الثورة، وقال له اكتب ما تشاء وبلا حدود. وحين فتح سلامة الجريدة لكتاب ديموقراطيين معارضين أو غير موالين، أُجبرته المخابرات على الاستقالة، ولم ينفع الرجل تكرار القول “أقسم بالله، إن الرئيس قال لي أن أنشر ما أريد”. بعد ذلك بفنرة قصيرة توفي سلامة بأزمة قلبية.
نجد الازدواجية كذلك مع الزوار الخارجيين. كان أمير قطر مثلا قد أرسل ابنه تميم بعد فترة وجيرة من اندلاع الثورة السورية واعتماد الحل الأمني تجاهها. رجا الضيف من بشار أن لا يمضي أكثر في خيار العنف، واعداً بالمزيد من الدعم المالي. كان رد بشار إن الأمور ليست بهذا السوء الذي يتصوره، وبعد ذلك (نيسان، أيار) شن حملة عسكرية على المناطق الثائرة. ثم جاء الاقتراح القطري التركي بموافقة أميريكية: اكبح المخابرات وقوى الأمن وجهز لانتخابات تعددية وسوف ندعمك في هذه الانتخابات، أصغى بشار باهتمام وبدا راغباً في الأخذ بالنصيحة، ولكن أفعاله لم تكن تصالحية بأي شكل. “لا نريد أن نقابل أناس لهم توقعات ومطالب عالية وغير معقولة. لا نريد أن نلزم أنفسنا بوعود لا نستطيع تنفيذها”، قال بشار لمناف. يقول بشار إذن إننا لا نريد أن نتخلى عن السيطرة التامة. هذا هو الأساس الذي جعل المسار الكارثي يشمل سورية، الأساس الذي يلخصه عنوان الكتاب “الأسد أو نحرق البلد”.
قد يعتقد البعض أن بشار مغلوب على أمره أمام تشدد المتشددين الأقوياء في نظامه، كما اعتقد مناف وتجرأ، بفعل قناعته هذه، أن يعرض على بشار استعداده لتنفيذ انقلاب واعتقال ماهر الأسد وحافظ مخلوف، على أن يكون بشار معه، فكان رد هذا الأخير: “مشكلتك أنك لين أكثر مما يجب”. الواقع كان خيار المواجهة العنيفة متخذاً قبل أن تصل موجة الثورات العربية إلى سورية، كما كشف منشقون عن النظام شاركوا مع أعلى مستويات اتخاذ القرار، في مناقشة الرد على التحرك الشعبي المتوقع حدوثه في سورية. وكان قرار النظام بعدم التراجع أمام المتظاهرين متخذاً، استناداً إلى أن تراجع النظام سيقود إلى المزيد من المطالب وتعزيز قوة الحراك ما سيؤدي إلى “سقوط النظام”. لذلك دخل النظام المعركة على أنها معركة حياة أو موت.
على سبيل المثال، هل كان عزل عاطف نجيب (ابن خالة بشار ورئيس فرع الأمن السياسي المسؤول عن اعتقال وتعذيب أطفال درعا الذين كتبوا على الجدران “إجاك الدور يا دكتور”) ومحاكمته والإفراج عن الأطفال والتعويض لهم ومواسات عائلاتهم، سوف يضع حداً لاحتقان الناس ورغبتهم في الخلاص من النظام؟ رغم افتراضية السؤال، ورغم أن الكثيرين يعبرون عن قناعة بأن الأمر كان سينتهي عند ذلك الحد، نرجح أن البديل الوحيد عن المسار الكارثي الذي تحقق في سورية، هو أن يقبل النظام طوعاً الدخول في مسار تغيير حقيقي ينتهي بتفككه، على الطريقة التي شهدها النظام السوفييتي في عهد ميخائيل غورباتشيف (1985-1992). مع ذلك يبقى لدى بشار ودائرته اللصيقة ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين قلق وخوف من الشارع لم يكن لدى القيادة السوفييتية التي اتخذت مسار البيريسترويكا.
الديموقراطيات تحب وتحابي الأقوياء بدلاً من محاسبتهم
في التعامل مع ثورة 2011، لم يقرأ نظام الأسد الابن في كتاب حماة فقط بل وفي كتاب العلاقة مع الغرب أيضاً. في 1984 أصبح فرانسوا ميتيران (Francois Mitterrand) (صديق صهر طلاس أكرم عجة) أول رئيس فرنسي يزور سورية منذ استقلالها. ومن دمشق أنكر ميتيران أن يكون لسورية صلة باغتيال السفير الفرنسي في لبنان 1981، أو بتفجير القاعدة الفرنسية في بيروت بعد عامين حيث قتل 58 جنديا فرنسياً، أو بالعديد من عمليات الاغتيال التي طالت معارضين سوريين في فرنسا وأوروبا. “لا شيء يثبت مسؤولية سورية، وطالما أن الرئيس الأسد يؤكد أن لا علاقة لسورية في ذلك، لا أرى ما يدعو للشك في كلامه”. كان لدى الحكومة الفرنسية أدلة عن تورط النظام السوري في هذه العمليات، ولكن ميتيران تغاضى عن كل شيء وذهب إلى دمشق بأمل تخفيف التوتر وتحقيق تعاون مع الأسد لكبح موجة العنف التي كانت تطال فرنسا ودولاً أوروبية أخرى على يد جماعات راديكالية في الشرق الأوسط. العبرة إذن هي أن استهداف الدول الأوروبية يجعلها تحابيك كي تأمن جانبك.
نجحت هذه السياسة حتى مع أميريكا عقب احتلالها العراق، ثم انخراط نظام الأسد في دعم الجهاديين في العراق، فقد وجد الأميريكان من دراسة الوضع في العراق في نهاية 2006 أنهم في مأزق وأن الأفضل لهم التعاون مع سورية وإيران، وهذا أبعد سيف مقتل الحريري عن رقبة بشار. الشيء نفسه حصل عقب دعم التحول الإسلامي في الثورة السورية والعمليات الجهادية التي استهدفت فرنسا التي كانت رأس حربة العداء لنظام الأسد.
في العلن ظل الموقف الأميريكي والأوروبي مضاداً للأسد، ولكنه في الحقيقة لم يكن كذلك، وهذا ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوصف الغرب الذي يطالب بعزل بشار بأنه منافق. بدت اللوحة منذ 2014 كما لو أن هناك تقسيم عمل بين الولايات المتحدة التي تفرغت لمحاربة “داعش”، والنظام الذي تفرغ لمحاربة المناطق الثائرة.
الأداة الإسلامية ذاتها التي تبقى صالحة للاستخدام على طول الخط، والتي لها مفعول السحر فتجعل اليمين واليسار الأوروبي يكررون مع البرلمانية الفرنسية فاليري بوير (Valerie Boyer) التي زارت سورية في 2016، والتي أصبحت لاحقاً متحدثة باسم الجمهوري فرانسوا فيون (Francois Fillon)، المرشح الرئاسي (2017): هل تفضلون التحدث مع داعش أم مع بشار؟
وقع الكتاب في النفس السورية
قد لا يضيف الكتاب كثيراً إلى من تابع الصراع في سورية منذ بدايته، وإن كان يغني القارئ بتفاصيل وأضواء على زوايا “من داخل القصر”، ليست في متناول عموم المتابعين عادة. يستفيد الكاتب من لقاءات مع شخصيات قريبة من رأس الهرم. ورغم أنه لا يستسلم تماماً لروايات محدثيه “القصريين” إلا أن رواية هؤلاء تشكل النسيج الأساسي للكتاب ولا يعدّلها سوى شيء من التحفظ الطفيف من قبل الكاتب. منظور هؤلاء الرواة، إضافة إلى النزعة الصحفية الأمريكية التي تبالغ في دور الفرد ودور النازع الشخصي في تفسير الحدث، فيبدو المحامي السوري مازن درويش ثائراً لأن أباه كان معتقلاً في زمن الأسد الأب، ويبدو الفنان السوري خالد الخاني كذلك لأن أباه قتل على يد نظام الأسد الأب في حماة 1982، كل هذا يساهم بنسبة كبيرة في تحديد الصورة العامة للعمل.
لا يخفي الكاتب موقفه، فهو ينحاز، دون استدراك، إلى قضية الشعب السوري الساعي للتحرر من سيطرة عائلة حاكمة، فخخت المجتمع من خلال تغذية عصبيات لا تتوافق مع الوطنية السورية. ويبدو جهد الكاتب واضحاً في السعي إلى معرفة وفهم تطور الحدث منذ بداياته وإلى تلمس حساسيات المجتمع السوري والاستثمار السياسي فيها لجهة تأجيجها وتوظيفها. مع ذلك تشعر خلال قراءة الكتاب أن الكاتب يحيل المأساة السورية إلى رواية للقراءة يحضر فيها الحوار “الروائي” والوصف المستفيض، ولاسيما للأماكن الراقية، والذي سوف يبدو للقارئ متنافراً مع الحدث، أو قد يبدو تقليلاً من التركيز على الحدث. لا تستطيع أن تهرب من الشعور بأن متطلبات القارئ الغربي تحكم العمل أكثر من أي شيء آخر، بحيث يؤلمك أن تتحول مآسينا إلى “روايات” صحفية خارجية عن واقع فظيع ولكنه يبقى واقع “آخر”، روايات مصنوعة لتسلية قراء أميريكيين تدغدغ لديهم الإحساس بالعلو فوق هذا النمط “المتخلف” من المآسي التي تبدو كأنها مجرد ولائم للصحافة ومناسبات للجوائز.
موقع راتب شعبو