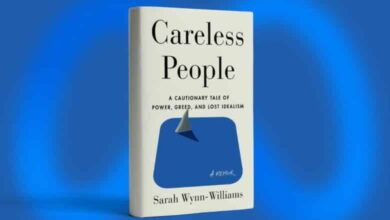ثلاثة قراءات لكتاب “من تدمر إلى هارفارد” لبراء السراج

قراءة في كتاب: من تدمر إلى هارفارد/ أحمد العربي
لبراء السراج شاب سوري مقيم في أميركا، يوثق لاعتقاله عام ١٩٨٤م على يد النظام السوري على خلفية الصراع بين النظام وجماعة الطليعة المقاتلة، حيث توسع النظام السوري باعتقال الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الديمقراطية. سُجن لمدة أحد عشر عاما، أغلبها في سجن تدمر، ومن ثم خرج من السجن عام ١٩٩٥م، وغادر بعد سنة الى أمريكا، ودرس هناك وأصبح طبيبا اختصّ وحصل على الدكتوراة عام ٢٠٠٨م، في زراعة الاعضاء في مدينة شيكاغو الأمريكية.
كانت تجربته في السجن والاعتقال تلح عليه أن يوثّقها و يكتب عنها، لكنّ تذكر ماعاش من آلام وعذاب وذكرى من تعذيب وإعدام هناك، جعله يتراجع دائما. الى أن جاء الربيع السوري في آذار ٢٠١١م، عندها بدأ في كتابة شهادته عن سجنه المديد. ليؤكد من خلال ذلك، أن الظلم والقهر الذي عاشه الشعب السوري، أدى إلى ثورته على النظام، التي كانت حتمية وضرورية.
يبدأ البراء شهادته من هذا التقديم، ويعود بعد ذلك ليتحدث عن نفسه، وذلك في اوائل عام ١٩٨٤م، إنه من عائلة حمويّة، تسكن في مدينة دمشق لهم فيها منزل، كما أن لهم أيضا بيت وأملاك في حماة، كان في السنة الثالثة من دراسته في كلية الهندسة الكهربائية، عمره احدى وعشرين عاما. وكانت قد مرّت سورية منذ سنوات بأحداث الصراع بين الطليعة المقاتلة والنظام السوري الذي استثمر ذلك ليبطش بالشعب السوري وقواه المعارضة، ارتكب كثيرا من المجازر، أكبرها في مدينة حماة حيث هدم أحياء وقتل عشرات الآلاف من أهلها، وكذلك في مدينة حلب وغيرها من المدن السورية.
كان النظام قد اعتقل أحد اخوة البراء قبل فترة لمدة شهر ونصف وأفرج عنه. البراء شاب متدين تردد على مساجد دمشق، وحضر بعض الدروس الدينية، لكنه لم يلتزم مع أي تحزب، وعندما تصاعد الصراع بين النظام وجماعة الطليعة وبعد اعتقال أخيه، أصبح أكثر حذرا بالنسبة لإظهار تدينه وتردده على المساجد. أحسّ أنه مراقب من خلال ذهابه للجامعة.
في إحد أيام ذهابه للجامعة وأثناء التفتيش تم التحفظ عليه من قبل الأمن، اقتيد إلى أحد الفروع الأمنية، واكتشف أنه معتقل. ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلة عذابه واعتقاله. طالبوه في البداية أن يكتب كل شيء عن نفسه، كتب ولم يعجبهم، طالبوه أن يقدم اسماء شباب من الطليعة المقاتلة او الإخوان المسلمين، أنكر في البداية، وبدأت رحلة التعذيب والإذلال. وكان لا بد له أن يقدم لهم بعض الأسماء، وأعطاهم اسماء لبعض الشباب من الذين قتلوا في الأحداث أو هربوا خارج البلاد. وهكذا أصبح نزيلا في الفروع الأمنية بين حماة ودمشق، وبعد زمن حوّل مع آخرين الى سجن تدمر. اعتمد البراء في توثيقه لما حصل معه، على تحديد الزمن اليوم والشهر والحدث. في تدمر كان الجحيم ينتظرهم، لقد تيقن أن تحويلهم الى هناك، كان المقصود منه، عيشهم في أجواء رعب وخوف وتعذيب وإذلال مستمر، مع صلاحيات لإدارة السجن تصل لدرجة القتل في تعاملها مع السجناء. كما كان في السجن محاكم عسكرية صورية، تجتمع بوقت لا يزيد عن دقائق، وكانت الأحكام تبدأ من سنوات سجن لتصل إلى المؤبد والإعدام، وكانت تحصل الاعدامات بشكل دائم وتختلف الأعداد في كل دفعة، يأخذوهم في وقت الفجر. أغلب المسجونين محسوبين على الإسلاميين، طليعة مقاتلة وإخوان، وسلفيين، كما وجد في السجن شباب محسوبين على بعث العراق، وبعض الشيوعيين، وكذلك الكثير من اللبنانييّن. اعتمدت ادارة السجن على التعذيب الجسدي والإذلال الدائم، ليلا ونهارا كل الوقت، ضرب وبطش وتعذيب، في التفقد الصباحي، وفي إخراجهم للتنفس، وكذلك عندما يؤخذون الى الحمّام، الذي لا يستغرق دقائق، يستحمون بشكل جماعي، الماء البارد وتحت الضرب. كذلك في الحلاقة التي تتحول إلى تجريح وتشويه لهم. هذا غير التعذيب الفردي العشوائي، بأدوات حادة، بورية معدنية، والدولاب والكبل الرباعي. يصاب الكثير منهم بعاهات من التعذيب، ومات البعض جرّاء ذلك. طالت الإعدامات حسب متابعة البراء ما يزيد عن أحد عشر ألف شخص في فترة وجوده في تدمر، الممتدة حوالي عشر سنوات، كما أنه سمع بالمجزرة التي حصلت في سجن تدمر عام ١٩٨٠م قبل سجنه باربع سنوات لقد سمع تفاصيل ما حصل، حيث حضرت طائرات هليوكابتر فيها عناصر من سرايا الدفاع، تم عزل السجناء في مهاجع معينة، واُخرج من لا يريدون تصفيته، وبدؤوا إلقاء قنابل على المهاجع، ومن ثم الدخول إليها، وإطلاق النار على السجناء الذين يستنجدون ويصرخون الله أكبر، استمر ذلك لساعات، حتى سكنت المهاجع كلها، لقد قُتل كل السجناء وكان عددهم حوالي الألف سجين او يزيد. كان ذلك ردا على محاولة فاشلة لإغتيال حافظ الأسد، حصلت عام ١٩٨٠م.
فصّل البراء ما كانوا يعيشوا داخل سجن تدمر، من كيفية الحياة والتعذيب اليومي والدائم، ليلا ونهارا، تحدث عن كثير من الشباب والكهول والأحداث مروا عليه وأثروا عليه، كانوا نماذج إنسانية. التجويع، التعطيش، الإذلال الدائم المقترن مع التعذيب الذي يؤدي في كثير من الأحيان الى الموت، كان البعض يتقدم لاستلام الطعام، وتحمل الضرب والتعذيب، والبعض يخرج للتعذيب بدلا عن آخرين كفداء وحماية الضعيف والمريض، عاش البراء مشاعرا إيمانية عميقة، يرى نفسه دوما تحت ألطاف الله، يلجأ له في كل نازلة، داوم على حفظ القرآن الكريم حتى ختمه، وكذلك حفظ الكثير من الأحاديث. كما عايش البراء الصّراع بين التوجهات الدينية المختلفة، سلفية ومذهبية وقرآنيّن، وكانت إدارة السجن تستثمر ذلك عبر خلق الضغينة بين السجناء، إلى درجة أن وظف بعضهم نفسه مخبرا لدى الإدارة، والمؤسف أن لا مكسب للمخبرين سوى واقع العار الذي يقعون به، يعذبوا ويضربوا وبعضهم قتل تحت التعذيب. عايش البراء وصول البعض لدرجة الإنهيار العصبي والعقلي، لدرجة الجنون. جرّب النظام جميع أنواع التعذيب والحرمان، على السجناء؛ التجويع، نقص مياه الشرب والنظافة، وأحيانا الإغداق بالطعام. تحدث البراء عن السجانين وانتقائهم، حيث كان أغلبهم من الطائفة العلوية، ممتلئين حقدا، تم تدريبهم على الضرب واستباحة السجناء، إلى درجة القتل، دون أي تبعات. وتحدث عن الأمراض السارية التي اصيبوا بها، السل والكوليرا، ناهيك عن الجرب وانتشار القمل فيهم. تنقل البراء بين الكثير من المهاجع، تعرف على آخرين أحبهم، وأفتقد الكثير ممن أعدموا لاحقا. في السجن محكمة عسكرية صورية، تأخر عرض براء عليها لسنوات، حاول أن ينكر ما فرض عليه من اعتراف في التحقيق، لكنهم حاسبوه على اعترافاته، وحكم لعشرين عاما. استمر سجن البراء في تدمر لسنوات طويلة، من ١٩٨٤م حتى بداية التسعينات. علم عن احضار الكثير من اللبنانيين سجناء الى تدمر، وكذلك بعض الشيوعيين، وبعث العراق، وعلم أن هناك مهاجع للنساء، هذا غير مهاجع الأحداث الذين كانوا بالمئات. ثم بدأ النظام بنقل الكثير من السجناء إلى سجن صيدنايا الذي بناه النظام حديثا للسياسيين، وتأخر البراء بالنقل له الى عام١٩٩٣م، اختلفت الحياة والمعاملة في سجن صيدنايا كثيرا عادوا إلى شروط حياة أقرب للإنسانية، في المعاملة والمأكل والمشرب، وحصول الزيارات لبعض السجناء. وصل خبر لبراء أن عائلته غادرت كلها لأمريكا، أحس بالغصة والفرح، لقد بعدوا عنه، لكنهم هربوا من ظلم مقيت. في سجن صيدنايا يعيش السجناء متكافلين في كل شيء، فالذي لا يأتيه زيارة ومال يساعده من يأتيه، وهكذا وجد البراء من أحتضنه وساعده. كان السجن مختلطا بين كل الإتجاهات السياسية. طال الزمن على البراء في السجن. زال خوفه من الإعدام بعد نقله لسجن صيدنايا، ولكن خاف أن يستمر سجنه لعشرين عاما. كان يحضر لقاءات مع مسؤولين أمنيين كبار مثل علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية وآخرين، ولأكثر من مرّة، وكان آخرها ١٩٩٥م، وأعطي إخلاء سبيل، وخرج من السجن، إلى فرع التحقيق، ثم مجددا الى الحرية.
بحث البراء عن أهله وعلم أنهم غادروا لأمريكا، وصل لأقربائه، ساعدوه وبدأ رحلة تجهيز نفسه للسفر إلى أمريكا، انهى تخلفه عن الجيش لكونه معتقلا، وحصل على جواز سفر، وسافر الى أمريكا ملتحقا بأهله، استفاد من تعلمه الإنكليزية في السجن، وبدأ رحلة التعلم ليصبح طبيبا مختصا في زراعة الأعضاء في شيكاغو عام ٢٠٠٨م. كما ابتدأ كتابة سيرته الذاتية وشهادته، التي كتبها مطلع الثورة السورية عام ٢٠١١م.
في التعليق على الشهادة -السيرة- أقول:
ها نحن أمام شهادة أخرى عن ما عاشه الكثير من شبابنا السوري في سجن تدمر وفي غيره من السجون والمعتقلات، وأن درجة استباحة إنسانية الإنسان لهم، لا تُقبل بأي معيار، ومهما كانت أفعالهم، وأن مظلومية السجون والمعتقلات، هي نسخة مركزة عن مظلومية مجتمعية عامة، استمرت لعقود، عاشها كل الشعب السوري وذاق ويلاتها. وأن ثورة الشعب السوري في عام ٢٠١١م، كانت نتيجة حتمية لما كنا نعيشه من ظلم وقهر واستغلال وفساد وطائفية واستبداد، وأن الثورة كانت الحل لاسترداد الحقوق والحريات وبناء مجتمع العدالة والكرامة والديمقراطية.
الكتاب شهادة أخرى لكي لاننسى…
———————————
الفتى الذي نجا من مقصلة تدمر/ شعبان عبود
الراوية التي أهداني إياها الكاتب “محمد برو” وضعتها قرب سريري منذ عدة أيام، أنظر إليها من بعيد، لا أجرؤ على تقليب صفحاتها، أعرف أن وجعاً كثيراً ينتظرني بين صفحاتها، يكفي ما تعرضنا له نحن السوريين من ألم وقهر منذ نحو عشرة أعوام، يكفي ما شاهدناه من موتنا وموت بعض من أهلنا وأحبتنا وأصدقائنا، يكفي ما عايشناه من ألم التشرد واللجوء هرباً من البراميل المتفجرة والقصف بالصواريخ وبالسلاح الكيميائي أيضاً، يكفي.
لكن الراوية بجانبي وعنوانها “ناج من المقصلة” فيه إغراء ما رغم ما يحمله أيضا من احتمالات القراءة عن الموت الرهيب الذي سمعنا عنه في سجن تدمر سيّء الذكر. الإغراء يتمثل بحكاية مؤكدة عن النجاة، يوجد عنصر جذب سري وغامض في العنوان، فإذا كانت كلمة “المقصلة” ستجعلنا نتوقع أن نقرأ عن قصص الموت الرهيب في ذلك السجن، فإن كلمة “ناج” تعدنا بالحياة وتعدنا كذلك بكشف الأسرار ومزيد من القصص من داخل مملكة الرعب التي تسمى: الجمهورية العربية السورية.
تجرأت وفتحت الرواية بعد أن اتخذت قراراً داخليا وضمنيًا بأني لن أستمر في القراءة فيما لو شعرت أنها ستؤلمني، لكن الذي حصل أني وما إن بدأت حتى نسيت قراري ذاك، واستمريت بالقراءة حتى أنهيت الرواية في أقل من يومين رغم كل ما تضمنته من قصص عن الموت والتعذيب الوحشي الذي كان يحصل في سجن تدمر في الثمانينيات، الموت والتعذيب الذي يصعب وصفه ولا يتخيله عقل.
ربما لأن الكاتب محمد برو ضحك علينا منذ البداية وفعل ما يفعله الأب مع طفله في أول يوم له في الحضانة أو المدرسة حين يمسك بيد ابنه الصغير ويمشي معه رويدا رويدًا، ثم ليتركه للمرة الأولى وحيدا مع أناس غرباء وجدد. لكن مع الوقت سيكتشف الطفل أنه لولا هذا اليوم لما فهم ونضج وتعلم الحياة، ومع الرواية والاستمرار في قراءاتها سنكتشف أنه لولا هذه القصص في داخلها، والتي يرويها محمد برو الذي دخل السجن فتىً صغيرا، ما كان لنا أن نعلم ونفهم حقا ما هي جمهورية الرعب التي كنا وما زلنا نعيش بداخلها.
فتى عمره سبعة عشر عاما فقط يعيش مع أهله في حي الميدان بمدينة حلب تقع بين يديه صدفة نشرة ورقية كان يوزعها تنظيم الطليعة المقاتلة، وهي الصدفة التي ستتسبب في اعتقاله وعدد من زملاء صفه بالمدرسة ليبقى ثلاثة عشر عاما في السجن، ثمانية منها قضاها في سجن تدمر امتدت منذ عام 1980 حتى 1988 والباقية في سجن صيدنايا.
الفتى يروي اللحظات الأولى للاعتقال والمداهمة في البيت في ساعة مبكرة جدا من فجر أحد الأيام على مرأى من أعين الأم والأب. قائد دورية الاعتقال والجنود الذين داهموا البيت بأسلحتهم وعتادهم قالوا للأب: سنحقق معه خمس دقائق ونعيده لكم. لكن الخمس دقائق امتدت إلى ثلاثة عشر عاماً.
في حلب حيث تم اعتقاله أولا يتذكر: “كنّا نتسلق قضبان واجهة الغرفة لنطل عبر النوافذ إلى الخارج وإلى الطريق الذي تعبره سيارة أو سيارتان كل دقيقة، وهذه نافذتنا الوحيدة على العالم.. وكنت وهذه حالي آسى على تلك الشجرة التي أشرف عليها من نافذة زنزانتي فهي لا تبرح مكانها طوال حياتها”.
ثم تمضي الأيام والأحداث ليُقاد مع العشرات السجناء المكبلي الأعين إلى وسط الصحراء حيث يقبع سجن تدمر الرهيب وما إن يصل مع الآخرين وينزلوا من السيارة حتى تبدأ حفلة التعذيب والضرب حيث كان عشرات من السجانين والجنود بانتظارهم، ضرب وتعذيب تقشعر له الأبدان، فيما أجساد السجناء المتعبة من طول الطريق وظروف السفر بسيارة مغلقة لا تصلح حتى لنقل الحيوانات، لم تذق الطعام منذ أكثر من يوم ولم ترتوِ حتى بقطرة ماء. ليس ذلك فحسب، لقد سقط “خلدون” صديق الفتى – الكاتب محمد برو بجانبه ميتاً منذ اللحظات الأولى نتيجة الضرب العنيف على الرأس.
سنكتشف لاحقاً أن هذا الاستقبال ما هو إلا مقدمة بسيطة لما ينتظرهم من أهوال وموت تحت أخمصة البنادق لسجانين وجنود تم تأهيلهم جيدا ليكونوا وحوشاً ضارية يقتلون السجناء لمجرد ارتكاب خطأ بسيط غير مقصود، كأن تحاول أن تحمي وجهك ورأسك وتبتعد قليلا بحيث لا يصيبك السجان بالعصا التي تهوي عليك، وهذا ما حصل حرفيا مع أحد الضحايا، فتم قتله بمنتهى الوحشية أمام أعين الجميع، لمجرد أن السجان شعر بالخزي حين هوت العصا في الفراغ دون أن تصيب هدفها.
الألم لا يتعلق فقط بالتعذيب، فكل التفاصيل في سجن تدمر مرتبطة بالوجع، طعام الإفطار، بل ربما طعام اليوم كله في إحدى المرات كان سبع حبات فقط من الزيتون، وكان هناك أيضا صوت آلات معمل الأجرّ عند أطراف مدينة تدمر والذي يبدأ في ساعة مبكرة من اليوم ولا يتوقف رغم كل ما كان يحصل داخل السجن من تعذيب وصراخ وحفلات إعدام جماعية تتم بدقائق قليلة بعد محاكمات ميدانية سريعة ومعروفة نتائجها مسبقا. لقد كان القاضي المعين من قبل السلطات يتلذذ في إنهاء حياة السجناء وقلما نفد من حكم الإعدام إلا قلة قليلة:” وفي المحكمة الأخيرة هذه، تفتق ذهنه الألمعي عن مقايضة يجريها بين أب وولديه اللذين يحاكمان معه، فقد عمد إلى تخيير الأب الكهل بين ولديه ليختار من منهما سيُعدم ومن منهما سيبقى حياً”.
هذا ليس فيلم رعب من هوليود، وليست مجرد قصة قيلت عن قائل، بل هذه شهادة حية من داخل السجن ومثلها قصص كثيرة عن محاكمات السجناء، نتعرف عليها في الرواية.
ربما قدر الفتى- الكاتب محمد برو أن ينجو بالصدفة من الموت بعد أن اتهمته المحكمة العسكرية في حمص بالإعدام لارتباطه حسب زعمها بجماعة الإخوان المسلمين، فيما بعد يكتشف المقدم وقتها غازي كنعان الذي كان يدير الأمن العسكري في حمص أن هناك خطأ في هذا الحكم لأنه مجرد “حدث ” لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره بعد. هذا الاكتشاف أو الانتباه للخطأ لم يخفف فقط حكم الإعدام إلى عشر سنين من السجن، بل سيسمح للفتى أن يشاهد ويرى ويسمع ويحتفظ بذلك مدة أربعين سنة ليرويه لنا فيما بعد في “ناج من المقصلة “.
الرواية تحكي قصص أبطال استقبلوا قرارات إعدامهم فيما رؤوسهم مرفوعة، وقصص ضباط وأساتذة ومهندسين وخبرات وطنية كثيرة تم تعذيبها حد الموت ومن ثم قتلها، الرواية أيضا تتحدث عن أشخاص تم تجريب أنواع وابتكارات من فنون التعذيب ومن السلاح الكيماوي على أجسادهم فمات منهم من مات وبقي منهم من بقي ليكون مصيره الإعدام بعد نجاته من التجارب.
ومثلما الرواية تتحدث عن قصص الموت الرهيب، لا تغفل التفاصيل الإنسانية المتعلقة بالأمل والحياة، كتلك التي تروي شعور السجناء حين لامست بعد عامين وللمرة الأولى التراب المبلل بندى الصباح، لقد اكتشفوا بعد دهر أن أقدامهم لم تطأ إلا ساحات الإسفلت القاسية والإسمنت الخشن والحصى، لقد أقشعرت أجسادهم فرحا وحزنا في آن حين لامست بطون أقدامهم ذلك التراب الندي.
أيضا لقد فرحوا كثيرا حين دخل مهجعهم بالصدفة كيسا صغيرا يحتوي مسحوقا أبيض بعد سنوات، ليعرفوا لاحقا أنه الملح الذي لم يتذوقوه لسنوات، كيس الملح ذاك وصل إليهم بعد زيارة قام بها أهل أحد السجناء، فما كان من نحو مئة وخمسين سجينا إلا أن وزعوا الكيس فيما بينهم بعدل وإنصاف.
عندما فرغتُ من قراءة الرواية، قلت في نفسي: هل يعرف العالم ماذا جرى وما يزال يجري في سوريا؟ لا، بل هل يعرف السوريون أنفسهم ما كان وما يزال يجري في بلدهم وداخل تلك السجون!
تلفزيون سوريا؟
———————————–
سوريالية هولوكوست الأسد/ مالك داغستاني
كثيراً ما كرر الكتاب الغربيون الذين كتبوا عن بنية وتاريخ نظام الأسد الأب سؤالاً يكاد يكون موحداً ولكن بصيغ مختلفة. من الذي يحمي نظام حافظ الأسد رغم كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري وبحق مواطني الدول المجاورة وخاصة الفلسطينيين واللبنانيين؟ حتى اليوم لم يستطع أحد الإجابة على هذا السؤال، رغم بعض التفسيرات الغامضة والتي تحيل السبب إلى اتفاقات سرية دولية، وبخاصة مع تل أبيب لتنفيذه دوراً وظيفياً يؤديه.
في السنوات العشر الأخيرة وبعدما كرر الأسد الابن جرائم أبيه، وفاقه بالكثير منها لجهة تدمير المدن والبلدات السورية، وقتله لمئات الآلاف بكافة أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الكيميائي، وتهجير الملايين وتغييبه في السجون لعشرات الآلاف وقتلهم تحت التعذيب، يزداد هذا السؤال إلحاحاً، لكن غالباً لا يطرحه اليوم سوى ضحايا النظام من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين وبعض الكتاب العالميين المهتمين، أما مسؤولو حكومات الدول فإنهم سيتحدثون عن أزمة سوريا وتفاصيلها وأطراف الصراع فيها دون الاقتراب من جوهرها وبشكل خاص السؤال عن خيمة الأمان الدولية التي تظلل وتحمي هذا النظام منذ نشأته، ولا أحد استطاع تقديم تفسير أن كيف يبقى نظام في الحكم وقد ارتكب كل ما ارتكب بما يشكل سابقة لا يوجد ما يشبهها في التاريخ الحديث؟.
صور قيصر الذي ثبت لدى كل الخبراء الذين قاموا بفحصها أنها صور حقيقية لجثث آلاف قتلوا تحت التعذيب، والتي عرضت في العديد من المحافل الدولية، كانت لتطيح بأي حكومة في أي بلد من العالم، لكن في حالة نظام الأسد لم تستدعِ من صناع القرار الدوليين سوى الإدانات والشجب والضجيج الإعلامي مع مزيد من التعاون الأمني السرّي مع مرتكبها.
“ليس لدي أحد ينتظرني خارج السجن” سيقول لي شاب في صيدنايا. من المرات القليلة التي أتيح لي الإسهاب بالحديث مع شخص من الإخوان المسلمين، كانت مع هذا الشاب المعتقل في مدينة حماة عام 1982. “عائلتي، أبي وأمي وإخوتي، وأعمامي وأبناؤهم الذين يسكنون في الحي ذاته، جميعهم قتلوا في المجزرة”. كان الناجي الوحيد من العائلة. لفتني أن طريقته في الرواية لم تكن تختلف في شيء عن الشهادات المصورة الحية لكبارٍ في السن نجوا من الهولوكوست، الذي تابعتُ الكثير منه بحسب ما أوردته الوثائقيات التلفزيونية والسينمائية. وهو يحمل الرقم/الشيفرة وشماً على باطن ساعده، كأثر مرئيٍ باقٍ من معسكرات الموت، يتحدث من كان طفلاً يوم الجريمة، كيف نجا بعد إعدام عائلته في معسكرات الموت أو في أفران الغاز النازيّة. الفارق الوحيد أن الناجي من الهولوكوست كان نجا من الموت وخرج إلى الحياة ليروي ويدلي بشهادته لجمهور يتبنى قضيته، بينما نجا هذا الشاب من مجزرة حماة ليذهب إلى جحيم سجن تدمر، دون أن يوصل لأحد في العالم ما حدث له ولعائلته ولمدينته.
بعض أفراد العائلة قتلوا في الشارع، والبقية تمَّ الإجهاز عليهم أثناء التحقيق معهم في المدرسة الصناعية، حيث نقلوا إلى هناك مع آلاف المعتقلين الآخرين وحشروا في غرف الصفوف وصالات الورشات. كان الوحيد الذي نجا من تلك المجزرة، فتم تحويله إلى سجن تدمر. ليتعرض هناك للمحكمة الميدانية التي تطلق أحكام الإعدام لأتفه الأسباب، ومع ذلك أصدرت تلك المحكمة الحكم ببراءته، ليبقى بعدها في تدمر لسنوات قبل أن ينقلوه من مهجع “الأحداث” كما كانوا يطلقون عليه هناك إلى سجن صيدنايا، ومن المعروف أنه لم يصل إلى صيدنايا بعد تدمر، إلا الأبرياء الذين لم يكونوا يستحقون حتى التوقيف لساعات في بلد آخر لا يحكمه نظام الأسد.
تقدّر معظم المنظمات الحقوقية المحلّية والدولية تصفية ما بين 15 و17 ألفاً في سجن تدمر خلال حقبة الأسد الأب، معظمهم أعدم في مطلع الثمانينات، ولم يصرح النظام عن مصيرهم حتى اليوم. نعم، مات الآباء والأمهات وهم ينتظرون خبراً لم يصلهم عن مصير ابن لهم. أبناء وإخوة وزوجات كبروا وللآن لم يعلموا مصير الغائبين في ثقوب الأسد السوداء. مع مطلع التسعينيات، وبداية أول عفو عن السجناء السياسيين في سوريا، وخروج المئات منهم، سيعرف بعض الأهالي مصير أبنائهم من روايات السجناء الخارجين، ممن عاشوا معهم وربما شهدوا مصيرهم/ إعدامهم، وسيبقى الآلاف دون أن يعرف ذويهم عن مصيرهم حتى اليوم. ولست هنا بصدد الحديث عن المفقودين في عصر الأسد الابن بعد عام 2011 فهم بعشرات الآلاف، ويُعتقد أن معظمهم قد تمت تصفيتهم.
يذكر تقرير أنجزه باحثون وخبراء حقوقيون ربيع عام 2010 بدعم من منظمة “فريدوم هاوس” في واشنطن، أن تقريرهم عن واقع الاختفاء القسري في سوريا، يأتي بعد إهمالٍ حقوقي يصيب متابعه بالذهول، خصوصاً بعد انكشاف ما جرى داخل السجون السورية، وطرق التعذيب الفظيعة وحالات القتل المهولة التي جرت في السجن بدون حساب ولا حتى أي مراجعة حقيقية، مما أسس لأكثر أنظمة الشرق الأوسط شمولية وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
في العفو الأول عن السجناء السياسيين عام 1991وكنا في سجن صيدنايا، سيتلو مساعد السجن أسماءً، من ضمن من صدر العفو بحقهم بحسب القوائم التي بين يديه، وسيجيبه من يعرف أصحاب تلك الأسماء، أنهم ما زالوا في سجن تدمر، ما يقدم دليلاً مأساوياً عن مدى الاهتمام الإداري لنظام الأسد بمصائر السجناء. لكن الأدهى والأكثر مأساوية، والذي لا يمكن أن يحدث في بلد آخر، ولكنه حدث في سوريا الأسد، هو تلاوة أسماء شملهم العفو ممن كانوا قد أعدموا في سجن تدمر قبل سنوات.
لم يكن الشاب الحموي يحمل على زنده الشيفرة النازية وهي يدلي بروايته دون كاميرات وتصوير، ودون جمهور يهتم سوى زميل يشاركه مأساة الاعتقال، لكنه كمثل ملايين السوريين كان وهو يروي يحمل في روحه شيفرة العار التي تفيد بأنه قد عاش في عصر نظام الأسد.
تلفزيون سوريا
————————–
========================