أن تصل إلى مركز المتاهة، وتقرأ كلّ الكتب ثم…/ عمار المأمون
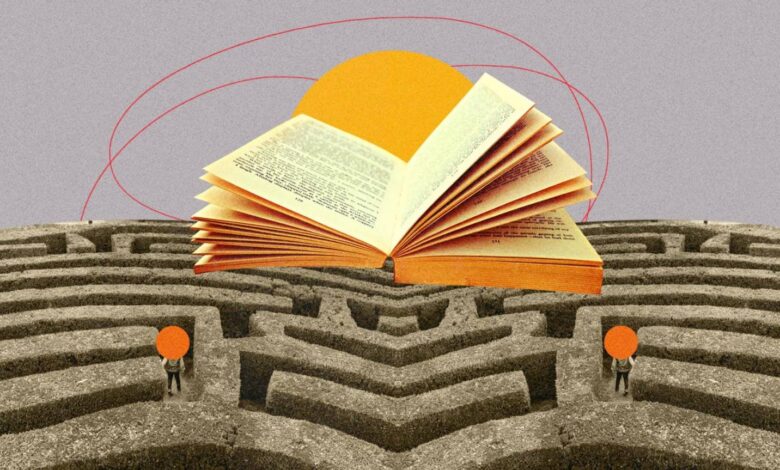
يفترضُ تبنّي واحد من أشكال الحكايات البورخيسية متاهةً من نوع ما: مكتبة كبيرة، حديقة متشعبة، نفقاً سرياً وكتاباً ضائعاً، لا نقرأ عنه إلا في حواشي الموسوعات المتخيلة الناقصة، لنكتشف لاحقاً، أن شخصاً ما، يكرّر أحداثاً تقوده إلى المتاهة. نُصدم لاحقاً بأن هذا الشخص يتبع خطوات شخص آخر، هذه الخطوات حلمت بها إحدى الشخصيات المذكورة في الكتاب الضائع، وفي نهاية المتاهة وحين الوصول إلى مركزها، تظهر أمامنا حقيقة مفادها أن من يبحث عن الكتاب كان مجرّد شخص بائس راوده حلم يقظة، وهو يقرأ ترجمة سيئة ومختصرة لدون كيخوتة، مقتنعاً أن المؤلف هو سيدي حامد بن الجيلي.
الصيغة السابقة تحوي مفارقة ترتبط بمضمون الكتاب الضائع أو الذي تم إيجاده، والمكان الذي كان موجوداً به، وتكشف أن هناك من يمتلكون الكتب ولا يقرؤونها، أو لا يقدرون أهميتها، خصوصاً إن كان الكتاب مختفياً في مكتبة. والراوي يحاول في هذه الحالة أن يكون محور الحدث، كونه من قام بالبحث أو أنقذته المصادفة، ليجد نفسه مع الكتاب الذي سيكشف له نهايةً سخف بحثه، ما دفع البعض إلى الكتب المتخيّلة، فقط لابتداع الطريق والمتاهة.
هذا النوع من الحكايات يصيب القارئ بالعدوى، يبحث في تواريخ الكتب التي يمتلكها أو وجدها عن قصّة أو مفارقة ما، وكأن الرغبة بالحكاية تفوق أهمية الحكاية نفسها، إذ تفترض مكونات هذه الحكايات أيضاً أن “القارئ المتمكّن” قادر على رصد الخطوط العامة للحكاية وطبيعة الصراع، وكل هذه المعايير التي يمكن أن تلخص فيها حكاية مسرحية هاملت بأنها “قصة شاب مثقف يحب الكتب، يحاول الانتقام من عمه الذي قتل والده”، وأيضاً قادر على رصد مكونات الحكاية “الأخرى”، حكاية الكتب، من أجل أن يجد المتاهة والنص الضائع والحلم في هاملت الذي قال لهوراشيو: “في السماوات والأرض يا هوراشيو أكثر مما حلمت به أنت وفلسفتك”.
المثير للاهتمام أن كل القرّاء الباحثين عن حكايات الكتب، يفترضون أن كل كتاب يحوي دعوة للقارئ كي يطرح أسئلة أو يجيب عليها في كتب أخرى، وهنا تظهر مفارقة أخرى هي أن الكتب تحمل “عظة” ما أو هالة سامية: كلما قرأنا أكثر كلما عرفنا المكونات الخفية وتغلغلت فينا المعرفة أكثر.
إذن، إن قرأ الجميع جميع الكتب الموجودة، لابد من الوصول إلى خلاصة مفادها: علينا عدم قتل بعضنا البعض، والتيقن بأن الحيوانات الناطقة كائنات متخيّلة.
هذه المسؤولية المفترضة على من يقرأ والفضول المرتبط بها، تظهر على شكل أسئلة عن القراءة، سأستعرض اثنين منها لا أمتلك لهما أي جواب:
– أثناء تشاتم صديقين لي على صفحات التواصل الاجتماعي، صديقين درسا المسرح ونظرياته وتحليل نصوصه، كتب واحد منهما للآخر: “كيف يمكنك أن تتهمني بهذا الكلام الساقط وأنت قد قرأت هاملت؟”
– إحدى أساليب التعيير التي لاحقت المترجم صالح علماني بسبب مواقفه السياسية كانت: “كيف يمكن لمن قرأ خريف البطريرك أن يكون مؤيّداً لدكتاتور؟ ناهيك عن ترجمة هذا الكتاب؟”.
غرابة هذا السؤال والصيغة الهجومية فيه تفترض أن من “قرأ” مجموعة محددة من الكتب، وصل إلى خلاصات محددة تتناقض كلياً مع مواقفه وتصرفاتها الواقعية، كما أن هذا السؤال يفترض أيضاً أن للكتاب طاقة سحرية قادرة على إدهاش القارئ، تشابه تلك القدرة التي تمارسها الكتب الدينيّة في تفعيلها للمخيّلة، إن تم النظر إليها كحكايات لا كحقائق.
الكتب التي جلبها كورونا
مظفر النواب في طهران، وخالي العزيز نابليون في الشّمال… باعة الكتب القديمة في إيران
“الكتب من لبنان ومصر والخليج وكندا أيضاً”… مكتبة “خان الجنوب” العربية في برلين
هنا يظهر مرة أخرى الحالم بالمتاهة، الكتاب الضائع أو الذي لم ينتبه له أحد، والقادر على تغيير كل شيء، عقلية صاحبه وطبيعة المكان الذي وجد فيه. هذه الطاقة السحرية تجعل كل كتاب أشبه بتعويذة، إن حلّت أو رتلت، تغيّر وجه العالم ومن عليه، وكأن هذا الكتاب الضائع الذي لم يقرأه أحدهم، قنبلة موقوتة، مخبّئة، يكفي اكتشافها كي يتغير كل شيء. وهنا نعيد النظر في السؤالين السابقين: ربما من قرأ لم يقرأ فعلاً، ولم يتعظ بعدم جواز القتل أو الإيمان بالحيوانات الناطقة، أو لم يقرأ التوليفة المناسبة من الكتب، ولم يدخل بالأصل المتاهة أو يلاحظ وجودها.
هل قرأ صاحب المكتبة “غرفة في تل أبيب”؟
كان البحث عن الكتب في دمشق عام 2015 مهمة صعبة، عدد المكتبات محدود وثمن الكتب غال، والأهم، أن البحث عن الكتب الجديدة كان إشكالياً بسبب تأخر وصولها من لبنان، أما السبب الدفين فهو إدراك بعض دور النشر في لبنان، أن هناك مزوّرين في دمشق يصدرون طبعات “مقرصنة” ثمنها لا يتجاوز 10% من الثمن الأصلي، لكن الثمن في هذه الحكاية لم يكن مشكلة.
ذات العام، أخبرني أحدهم عن شخص يريد أن يبيع كتباً لديه بمبلغ زهيد، هذا الشخص صاحب مكتبة ولديه رف من الكتب يريد التخلص منه، بالطبع كأي مهتم بالكتب، رافقته ونقودي مكدسة في جيبي، كوني كنت من المستفيدين من فرق العملة، أي تضاعف ثمن الليرة السورية مقابل الدولار.
قبل الدخول إلى المكتبة لابد من أن أشير إلى مكانها، هي في حي ركن الدين، بصورة أدق، المكتبة تابعة لمجمّع (أحمد كفتارو) للعلوم الشرعية، لكنها ليست جزءاً منه، بل أقرب إلى المكتبات الجامعية.
المجمع سابق الذكر أشبه بمسجد كبير وجامعة، يَفدُها الناس من كل مكان لنهل علوم الدين، والمكتبة المقصودة تجاور الباب الرئيسي للمجمع، نهبط إليها بعدة درجات من الشارع الرئيسي، لنشاهد داخلها كل الكتب التي يحتاجها طلاب العلم هناك، من إحياء علوم الدين للغزالي انتهاء بسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وتسجيلات لخطب شيوخ متعددين، مسواك، عطورات ومسابح وكل ما يمت بصلة إلى الكيتش الديني الإسلامي.
هبطت الدرجات ودخلت المكتبة، أول سؤال كان في عقلي: “ما الكتب التي يمكن التخلص منها في هذا القلعة السنّية؟”، كانت هذه أول خيبة أمل، لأني ظننت بأن الأمر يتعلق بكتب تعليم الصلاة والصيام، إذن لابد من التحذلق، سألت صاحب المكتبة عن “كتاب المصاحف” للسجستاني، بالطبع فهم أني أسخر منه، وقال لي: “غير موجود! ما هو طلبك؟”. تدارك صديقي الإحراج، وقال له إني أريد شراء الكتب الرخيصة التي يريد التخلص منها.
توجهنا إلى أحد الرفوف الذي يحوي طبعات عديدة لكتب عن الوضوء والصلاة وأصولها، كتب واضح أنها لمن لا يجيد العربيّة. هنا ظننت أني تورطت ولابد أن أشتري شيئاً منها، أزاح صاحب المكتبة هذه الكتب، وقال لي: “تفضل!”، تاركاً إياي محتاراً بين روائح العود والهوغو بوس الرخيصين.
ما رأيته كان الأشد غرابة في ذاك السياق، وجدت مثلاً ديوان “على وشك الأسبرين” لأسعد الجبوري، سألت صاحب المكتبة: “هل تعلم من هو الجبوري؟”، لم يجب. روايات لعبد الرحمن منيف، محمد الماغوط، حيدر حيدر، لكن أبرز ما يثير الاهتمام هو كتابين لراجي بطحيش “غرفة في تل أبيب” و”بر-حيرة-بحر “، كانت صدمة كوني أعرف راجي، وأعمل معه في تحرير موقع “أنبوب.نيت” للأدب الراديكالي، وفيه نستضيف نصوصاً إيروتيكية متنوعة لا تعرف ممنوعاً إلى نكاح الحيوانات.
أخذت الكتابين وسألته مرة أخرى: “هل تعرف من بطحيش هذا؟”، قال: “لا”، وتفقد ساعته الالكترونية ذات الآلة الحاسبة.
-صمت-
اشتريت الرف بأكمله، وكانت المرة الأولى التي اقتني بها كتباً لبطحيش، كوني قرأته إلكترونياً سابقاً.
الغريب هو تواجد هذه الكتب هنا ضمن واحد من حصون العقل السنيّ، مفارقة هائلة أن نجد في متاهة من “كتاب الأغاني”، “فقه الجهاد” وتلك العناوين التي تمتد على 9 مجلدات، كتباً لا يعلم صاحب المكتبة محتواها ولا أسماء كتابها، ولا من اختار أنها مناسبة لطلاب الشريعة.
يمكن تعميق المفارقة وجدران المتاهة والقول إن هذا المكان تقام فيه الصلوات المفروضة والسنن والنوافل، وتحتدم النقاشات حول “طريقة صلاة النبي”: هل كان يضع يديه على صدره أو بطنه أثناء الصلاة؟ وإثر هذه العلامة، يتم تبادل تهم السلفيّة، وسط كل هذا نجد كتاباً لبطحيش “بر-حيرة -بحر”، ذا علامة التجنيس الغريبة “بورتريه منثور”، يتحدث فيه عن جنسانيته، أفلامه البورنوغرافية المفضلة وعلاقته مع أسرته.
بالإمكان تكوين حكاية عن حكاية كتب بطحيش هذه، وباقي الكتب الموجودة في الرف، وكيف أن مجمع كفتارو مازال قائماً، وهذه الكتب واحدة من مكتباته أو ضمن حرمه، بل ويمكن تطوير هذه الحكاية، وافتراض عدوى ما تنتقل من هذا الرف إلى كل الكتب في المجمّع، بل وبالإمكان الاستطراد وطرح سؤال على صاحب المكتبة نفسه، إن افترضنا أنه قرأ الرف بأكمله، أو أي أحد قرأ الرف بأكمله، كيف يمكن له أن يواظب على الحضور في المؤسسة الأيديولوجية المحكومة بعلوم الرجال والجرح والتصحيح؟
لماذا لا يقرأون الكتب الجيّدة؟
نحن المسحورين بالكتب والمؤمنين بالحكاية، نجد أملاً ما في هذه المتاهات والمفارقات والحكايات عن المخطوطات الضائعة والإهداءات الغامضة، هناك رهان على مكونات أبديّة لكل حكاية، نجد أنفسنا في إحدى اللحظات جزءاً منها، أو قادرين على رصدها في حياتنا اليومية. هذه المكونات تعيدنا للأسئلة السابقة عمن قرأ هاملت وترجم ماركيز وصاحب المكتبة ذات الرف “الخطير”، خصوصاً أن تراث الكتب والقراءة يخلب اللب. آلاف السنين من القرّاء الذين إن تصفحنا كتاب ألبيرتو مانغويل “تاريخ القراءة” لوجدنا أنفسنا بينهم.
لكن ماذا عن الآخرين؟ عن كل الذين مرّوا في المكتبة أسفل مجمع كفتارو وتجاهلوا كلياً الرف؟ أو أولئك اللذين “قرأوا” ولم يتوصلوا إلى “الحقائق” التي يفاخر بها القرّاء “الحقيقيون”؟ ماذا نسمّي هؤلاء، بعيداً عن التصنيفات السياسيّة ضمن الحقل الأدبي: “أمّيون”، “جهلة”، “ملاحدة بالحكاية”، “قرّاء سذّج”، أو “مُدْبرون” لأنهم أدبروا عن دين الحكاية ومكوناتها؟
ما نحاول قوله إن هناك مسؤولية تلقى فجأة على أحدهم بمجرد أن يمسك كتاباً، إذ نبدأ بوضع التصورات عنه، ونظنه اقتنع ببشارة الكُتب، وكل سلوكه سيختلف بجرد أن تدفقت الكلمات والأسطر أمام عينيه، وهنا المثير للاهتمام، عادة، ما يقلب العالم ويغير تكوينه حدث خارق، يلتف حوله الناس، يخادع حواسهم و إدراكهم، لكن فجأة تحول الكتاب إلى المعجزة ذاتها، لا أدري في أي زمن سحيق بدأ التبشير بالكتب ومعه بدأ تلاشي المعجزات التي حلت الكتب نفسها مكانها، و تحولت “فرقة الكتب” إلى الفرقة الناجية، بل إن أفلام نهاية العالم تبشر بنجاة كتاب واحد، سيعيد البشرية إلى حالها.
لكن ماذا لو كان فطراً، حوتاً أو واحداً من الشرائط المسجلة التي تجاهلتها كلياً في مكتبة مجمع كفتارو، والتي بدون حكاية، ستحرر القرّاء من مسؤولياتهم وتمنح المؤلفين راحة بالهم، خصوصاً أن هناك وصيّة للقراء تقول: “كل كتاب يحوي كلّ الكتب بداخله”، لكنها تفترض أن يقرأ أحدهم كلّ الكتب كي يجدها كلها في كتاب واحد.
نقرأ مقالاً منشوراً في المدن لأيوب المزيّن عنوانه “عبد الفتاح كيليطو… هل يقرأ فعلاً كل شيء؟”، وأكرر ذات السؤال بصيغة الماضي: “هل قرأ فعلاً كلّ شيء؟”. بصورة أخرى، هل هناك جدوى من قراءة كل الكتب، إن كانت النتيجة إنجاز كتب أخرى، أم أن هناك معجزة ما ستتحقق إن تمكن أحدهم من قراءة “كل شيء”، هل سيقف بوجه الديكتاتور مثلاً، هل سيتحرر من الأيديولوجيا ويقبل كل الكتب عوضاً عن واحد أو بضعة.
الإجابة عادة تنتمي إلى الحكايات الدينية: آدم نظرياً تعلم كل الكلمات، ثم اكتشف ما خفي منها عندما “تذوق” التفاحة، بالتالي هو قادر على معرفة كل تنويعات ترتيب الأحرف وكل ما تحويه من معان دفينة، يمكن التحذلق هنا إلى ما لانهاية، لكن، أجد نفسي إن استطردت في هذا التفكير، مُضطراً لتكرار ذات النهاية التي وصل إليها المزين في مقاله، وهي أن أقتبس من قصيدة “نسيم بحريّ” لستيفان مالارميه، بترجمة مغايرة أرتجلها: “الجسم تعيس! للأسف! وقد قرأت كل الكتب، سأهربنّ إذن، سأهربنّ إلى هناك، أتلمس طيوراً سكرانة، تراوح بين زبد مجهول وسماوات”.
ربما لحم الشاعر متعب من المتاهة، قرأ كل الكتب ليصل إلى مركزها، إلى الكتاب الضائع، وما إن وصل حتى قرر الهرب، هو الذي لم يُهمل أي واحد من الكتب، وجد نفسه نهايةً فارّاً، راكضاً وراء طيور سكرانة، لا يمكن التنبؤ بدربها، وكأنها تمشي في حلم، أو تلك التي نحلم بها ولا نستطيع التنبؤ بمكان وقوعها.
حاشية: ما لم أركز عليه في حكاية رف الكتب في مجمع كفتارو، هو ديوان أسعد الجبوري “على وشك الأسبرين”، بعد أن بحثت في كل مكتبات وبسطات دمشق عنه، فجأة ظهر أمامي دون أن يكون في بالي أبداً.
رصيف 22




