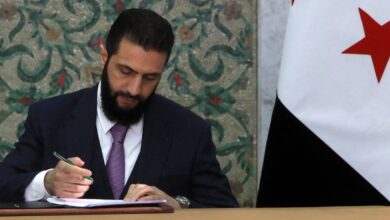شمال سوريا..الانفلات الأمني وسبل علاجه/ العقيد عبد الجبار العكيدي

بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين فصائل الجيش الحر وتنظيم “داعش” حصدت آلاف الأرواح من الطرفين، تكللت هذه المعارك بالنهاية في تحقيق نصر عسكري كبير عام 2017 في شمال سوريا، ضمن عملية أُطلق عليها “درع الفرات” وخاضتها فصائل الثوار بدعم وإسناد الجيش التركي ومشاركة قواته الخاصة، حيث نجحت العملية بدحر التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية من هناك.
أصبحت المنطقة الممتدة من مدينة إعزاز غرباً إلى مدينة جرابلس الحدودية شرقًا ، مروراً بمدينة الباب (التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم) محررة من النظام وتنظيم داعش وقوات قسد، تبعها في بداية العام 2018 عملية “غصن الزيتون” التي نجحت بطرد وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين، ثم عملية “نبع السلام” في خريف العام 2019 التي قطعت أوصال مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقضت على حلم الكيان الانفصالي، من خلال سيطرة فصائل الجيش الوطني مدعومة بالجيش التركي على مدينتي تل أبيض ورأس العين.
بعد هذه العمليات العسكرية الواسعة بدأ تحدٍ جديد تجلى بإدارة هذه المناطق من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني، الذي تشكل قبيل عملية غصن الزيتون بأيام قليلة، وبدا أن فرض الأمن وتحقيق الاستقرار من أصعب التحديات وأعقد الملفات التي واجهت الجميع.
على الرغم من تشكيل وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، وتأسيس الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والكثير من الأجهزة الأمنية، إلا أن المشكلة الأبرز التي أرخت بظلالها على الشمال السوري المحرر وسكانه هي حالة الفلتان الأمني والفوضى التي أصبحت تعم المنطقة.
خلفت حالة الفوضى انعكاسات سلبية على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد هذه المناطق عمليات اغتيال أو اختطاف أو تفجير عبوات ناسفة أوسيارات مفخخة في الأسواق والتجمعات، حاصدةً أرواح العشرات، بل المئات من المدنيين، ومستهدفة مقرات بعض الفصائل العسكرية وحواجزها. وصل الاستهداف إلى مبنى الحكومة المؤقتة في مدينة إعزاز ومقر وزارة الدفاع في قرية كفرغان، الذي راح ضحيته قامة علمية وعسكرية كبيرة هو العقيد الدكتور المهندس محمد عدنان بكار.
لم يقف الأمر عند التفجيرات، بل تجاوز ذلك إلى انتشارعمليات التهريب وتجارة المخدرات، عبر المعابر غير النظامية مع قسد والنظام التي أصبحت رائجة بشكل كبيرة في هذه المناطق في ظل غياب الرقابة الأمنية.
وهنا لا بد من التوقف عند أسباب هذا الانفلات الأمني في المناطق المحررة الذي يتجلى بما يلي:
أولاً، تعدد فصائل الجيش الوطني وافتقارها إلى هيكلية مؤسساتية واضحة وتراتبية عسكرية منضبطة.
ثانياً، ضم الفصائل العسكرية في الجيش الوطني للعناصر دون أي دراسة أمنية مسبقة، واهتمام الفصائل بكثرة أعداد مقاتليها على حساب النوع والمعايير الوطنية والأخلاقية والثورية.
ثالثاً، انتشار الفقر والحاجة وانعدام فرص العمل في المناطق المحررة، حيث أن غالبية الشباب يعملون ضمن صفوف الجيش الوطني، بسبب غياب فرص العمل وليس بدافع ثوري أوعقائدي، وهذا ما استثمرته استخبارات النظام والتنظيمات الإرهابية في تجنيد بعض ضعاف النفوس واستخدامهم لتنفيذ عملياتها الاجرامية.
رابعاً، غياب السلطة التنفيذية القوية وضعف الأجهزة الأمنية المختصة في كشف المجرمين وملاحقتهم ومحاسبتهم، وعدم امتلاك تقنية كشف المتفجرات والألغام، وقلة الخبرة والمعرفة لدى العناصر الموجودة على الحواجز وعدم إدراكهم لطبيعة مهمتهم وخطورة مهمتهم على أمنهم الشخصي وأمن المنطقة بأكملها.
خامساً، اكتظاظ المنطقة بالسكان والفصائل ممن هُجروا من كافة المحافظات السورية وزجهم في مساحة جغرافية محددة، وهم من حواضن وخلفيات اجتماعية متنوعة ومختلفة، وانتشار السلاح العشوائي وتصفية بعض الحسابات القديمة بين العوائل والأشخاص.
سادساً، عدم إنشاء جسم أمني موحد يضم ذوي الخبرة والاختصاص، وعدم الاستفادة من خبرات وتجارب الضباط المختصين المنشقين، سواء الأمنيين منهم أو العسكريين أو ضباط الشرطة.
سابعاً، عودة بعض العناصر والقياديين السابقين في تنظيم داعش إلى المنطقة تحت اعتبارات عائلية وعشائرية، ومنهم من انضم الى بعض الفصائل والأجهزة الأمنية بسبب المحسوبيات غالباً.
والسؤال الأبرز الآن: من المسؤول عن حفظ الأمن في المناطق المحررة؟
أولاً، تركيا، وهي صاحبة النفوذ في الشمال السوري المحرر، ومسؤولة عن إدارته بعد أن ساهمت بإعادة تهيئة البنى التحتية ومرافق الصحة والتعليم فيه، وقد بدأت تواجه بعض الانتقادات جراء الحوادث الأمنية الأخيرة، وبالتالي يقع على عاتقها إيلاء أهمية أكبر للوضع الامني وإيجاد حلول فاعلة.
ثانياً، الحكومة السورية المؤقتة التي يقع على عاتقها حفظ الأمن لعموم المنطقة عبر وزارتي الدفاع والداخلية، وما يتفرع عنهما من شرطة عسكرية ومدنية وقوى أمن داخلي وقضاء عسكري، بالإضافة إلى الاستخبارات بكل أفرعها وأقسامها.
ثالثاً، فصائل الجيش الوطني وحواجزها المنتشرة على كامل هذه الجغرافية، والتي تدير كافة المعابر المؤدية الى المناطق المحررة، مسؤولة بشكل مباشر عن حفظ الأمن ومنع عمليات التهريب ودخول الأشخاص المشتبه بهم.
رابعاً، وزارة العدل من خلال القضاء والمحاكم المدنية والعسكرية وتطبيق الاحكام الصارمة بحق المجرمين مما يؤدي إلى الردع.
خامساً، وزارة الإدارة المحلية متمثلة بالمجالس المحلية للقرى والبلدات بإنارة مداخلها وشوارعها وتركيب كاميرات المراقبة وتوزيعها بطريقة مدروسة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
لا شك أن الانفلات الأمني في المناطق المحررة، وانتشار عمليات الخطف والاغتيال وعمليات الاعتقال التعسفي سيؤدي إلى نتائج كارثية على هذه المناطق، يأتي في مقدمتها زيادة هجرة الأدمغة على نطاق واسع، ودفع العديد من الناشطين والإعلاميين والعاملين في المجالات الخدمية كالأطباء والمدرسين إلى البحث عن مناطق أكثر أمناً، وكذلك سوف تدفع لهجرة رؤوس الأموال، وتوقف عجلة الاقتصاد الضعيفة أصلاً في تلك المنطقة.
وأخيرا: فإن معظم المنظمات الإغاثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني سوف تحجم عن العمل في ظل ظروف أمنية غير مستقرة.
ولمواجهة ما سبق ومعالجة هذا الوضع يمكن تقديم مقترحات لضبط الامن في المناطق المحررة:
أولاً، توحيد الفصائل العسكرية في تشكيل له هيكلية وتراتبية عسكرية منضبطة ويقوده ضباط منشقين من ذوي الاختصاص والخبرة، يتبع فعلياً وليس شكلياً، لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
ثانياً، تشكيل جهاز أمني مركزي واحد ذو صلاحيات كبيرة يشمل كامل المناطق المحررة من ذوي الخبرة والاختصاص من ضباط الشرطة والأمن المنشقين عن النظام يتبع لوزارة الداخلية، وإلغاء كافة المكاتب الامنية للفصائل التي تعتمد المحسوبيات على حساب الكفاءات.
ثالثاً، إغلاق تام وقطعي لمنافذ التهريب مع قسد والنظام.
رابعاً، إعادة متابعة وملاحقة المشتبه بهم وأصحاب السوابق والمنتمين سابقا لداعش وقسد في كل المناطق.
خامساً، تكثيف التدقيق الأمني على المقيمين في المخيمات العشوائية في الشمال السوري.
سادساً، إصدار أحكام قضائية صارمة بحق المتورطين بالعمليات الارهابية والمتهمين بالعمالة للنظام وقسد وداعش.
سابعاً، اعتماد منظومة شبكة كاميرات مراقبة واسعة في شوارع المدن والقرى والبلدات بالتعاون مع المجالس المحلية تكون موصولة بنظام المعلومات لدى الأجهزة الأمنية.
ثامناً، تكثيف الحواجز المشتركة من الشرطة العسكرية والمدنية وتسيير الدوريات الليلية لضبط الأمن في كل المناطق ورفدها بالعناصر الأمنية المتدربة.
تاسعاً، التنسيق الكامل بين وزارات الحكومة المؤقتة المعنية بالملف الأمني وخاصة الدفاع والداخلية والعدل وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة.
لا بد أن نكون منصفين بحق المخلصين والغيورين من قيادات وعناصر الجيش الوطني الذين بذلوا جهوداً كبيرة لضبط الأمن ودعم الاستقرار وملاحقة الفاسدين، رغم قلة الموارد والدعم الحقيقي وكثرة المصاعب التي تعجز عنها دول وحكومات كبيرة ومستقرة.
المدن
حدود سوريا وبواباتها في قبضة حلفاء دمشق… وأعدائها/ إبراهيم حميدي
الحكومة تسيطر على 15 % من الخطوط مع الجوار… والبوابات مع لبنان تحت سيطرة «حزب الله»
مع تقلب السيطرة في سوريا وعلى حدودها خلال العقد الأخير، لا تسيطر الحكومة المقيمة في ثلثي البلاد ومعظم مدنها الكبرى سوى على 15 في المائة من الحدود مع الدول المجاورة ونصف معابرها الـ19 (يقع معظمها مع لبنان).
وللمرة الأولى منذ 2011، استقرت في السنة الأخيرة خطوط التماس بين ثلاث «مناطق نفوذ»، ولم يطرأ عليها تغير جوهري، حيث تسيطر الحكومة بدعم روسي إيراني على نحو 65 في المائة من البلاد (المساحة الإجمالية 185 ألف كلم مربع)، وست مدن رئيسية: دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، ودرعا ودير الزور، تضم 12 مليون شخص. في المقابل، تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية، بدعم من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، على نحو 25 في المائة من الأراضي، تضم نحو 3 ملايين شخص، ومعظم ثروات النفط والغاز والمياه والزراعة، ومدينتي الحسكة والرقة. كما تقع محافظة إدلب ومدن جرابلس وعفرين وتل أبيض ورأس العين التي تضم أكثر من 3 ملايين، معظمهم من النازحين، تحت سيطرة فصائل تدعمها تركيا، ما يشكل نحو 10 في المائة من سوريا، وضعفي مساحة لبنان.
– سيطرة وهمية
وجاء في دراسة نشرها الباحث الفرنسي فابريس بالانش في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، أول من أمس، أن «الحدود رمز السيادة بلا منازع، ولا يزال سجل أداء النظام خالياً تقريباً على هذا الصعيد. ويسيطر الجيش السوري على 15 في المائة فقط من الحدود البرية الدولية للبلاد، في حين تتقاسم جهات فاعلة أجنبية الحدود المتبقية».
وفي جنوب البلاد وغربها، تسيطر الحكومة السورية وتنظيمات مدعومة من إيران و«حزب الله» على 20 في المائة من حدود البلاد. يقول بالانش: «على الرغم من أن سلطات الجمارك السورية هي المسؤولة رسمياً عن إدارة المعابر مع العراق (البوكمال) والأردن (نصيب) ولبنان (العريضة وجديدة يابوس وجوسية والدبوسية)، فإن السيطرة الحقيقية تكمن في الواقع في أماكن أخرى، إذ يحتل (حزب الله) الحدود اللبنانية، وقد أقام قواعده على الجانب السوري (الزبداني والقصير) التي يسيطر منها على منطقة القلمون الجبلية. وبالمثل، تدير ميليشيات عراقية كلا جانبي الحدود من البوكمال إلى التنف. وتمتد قبضة القوات الموالية لإيران أيضاً إلى كثير من المطارات العسكرية السورية التي غالباً ما تكون بمثابة وسيلة لنقل الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى (حزب الله) وخط المواجهة مع إسرائيل في مرتفعات الجولان. ويكشف هذا الوضع عن اندماج سوريا الكامل في المحور الإيراني».
وكانت قوات الحكومة قد سيطرت على معبر نصيب مع الأردن في منتصف 2018، بموجب اتفاق روسي – أميركي – أردني قضى بتخلي واشنطن عن معارضين، مقابل عودة قوات الحكومة وإبعاد إيران. لكن فصائل تدعمها قاعدة حميميم الروسية تسيطر على مساحات واسعة من الحدود الأردنية. وأفاد التقرير بأنه رغم السيطرة على نصيب، فإن «حركة المرور لا تزال محدودة جداً حالياً، ووجود الجيش في محافظة درعا سطحي. ولإخماد المقاومة المتنامية في المنطقة بسرعة، اضطر النظام إلى توقيع اتفاقيات مصالحة، بوساطة روسية، تاركاً الفصائل المتمردة المحلية تتمتع باستقلالية مؤقتة وحق الاحتفاظ بأسلحة خفيفة. وحافظ المتمردون السابقون أيضاً على روابط قوية عبر الحدود عن طريق الحدود الأردنية، مما يمنحهم مصدراً محتملاً للدعم اللوجيستي في حالة نشوب صراع جديد». ورعت «حميميم» قبل أيام اتفاق تسوية جديداً قضى بدخول الجيش السوري إلى طفس (غرب درعا).
وتسيطر الحكومة على المعابر غير الشرعية مع لبنان، وتلك الخمسة الرسمية، وهي: جديدة يابوس – المصنع، والدبوسية – العبودية، وجوسية – القاع، وتلكلخ – البقيعة، وطرطوس – العريضة. وتوجد على طول الحدود معابر كثيرة غير شرعية، معظمها في مناطق جبلية وعرة، بحسب تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية.
وليست هناك معابر رسمية بين البلدين، لكن «خط فك الاشتباك» بين سوريا والجولان المحتل. وبعد 2011، كانت تسيطر فصائل على المنطقة، غير أن قوات الحكومة عادت إليها بدعم روسي في بداية 2018. كما أعيد في يوليو (تموز) فتح معبر نصيب – جابر مع الأردن الذي كانت قد سيطرت عليه فصائل معارضة في أبريل (نيسان) 2015. أما معبر الرمثا – درعا، فاستعادته دمشق بعدما فقدت السيطرة عليه منذ عام 2013.
– وكلاء وحدود
في عام 2013، بدأت تركيا في بناء جدار حدودي في القامشلي، معقل الأكراد شرق الفرات. ومنذ ذلك الحين، وسعت هذا الحاجز على طول الحدود الشمالية بأكملها. وكان أحد الأهداف منع التسلل من «حزب العمال الكردستاني» و«داعش»، ومنع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى تركيا التي تستضيف بالفعل 3.6 مليون لاجئ. وقال التقرير: «لا يزال العبور الفردي ممكناً عبر السلالم والأنفاق، لكن الشرطة التركية توقف معظم هؤلاء المهاجرين وتعيدهم بعنف إلى سوريا».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، شنت تركيا عملية عسكرية، بالتعاون مع فصائل موالية، وسيطرت على شريط بين تل أبيض ورأس العين في شرق الفرات الذي يخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». ودفع هذا الأخيرة لعقد تفاهم مع دمشق سمح بدخول الجيش الروسي والسوري إلى شرق الفرات، وتقليص مناطق سيطرة حلفاء أميركا وتركيزهم على القسم الشرقي من شرق الفرات على حدود العراق. وحلت الدوريات الروسية – التركية محل الدوريات الأميركية – التركية على خطوط التماس هذه لضمان انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» من منطقة الحدود التركية.
وعليه، فإن الجزء الوحيد من الحدود الشمالية مع تركيا الخاضع لسيطرة دمشق هو معبر كسب (شمال اللاذقية)، وحتى هذا المعبر تم إغلاقه من الجانب التركي منذ عام 2012. وباتت السيطرة على الجانب السوري من الحدود تباعاً على النحو التالي: أولاً المناطق حتى خربة الجوز من قبل التركمان الموالين لتركيا؛ ثانياً المناطق بين جسر الشغور وباب الهوى من «هيئة تحرير الشام»؛ ثالثاً حتى نهر الفرات من قبل الموالين لتركيا المعروفين بـ«الجيش الوطني السوري»؛ رابعاً حول عين العرب من قبل الجيش الروسي و«قوات سوريا الديمقراطية»؛ خامساً المناطق بين تل أبيض ورأس العين من قبل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة؛ سادساً من رأس العين حتى نهر دجلة من قبل الجيش الروسي و«قوات سوريا الديمقراطية».
ماذا عن المعابر؟ تتقاسم جهات عدة، وبدرجات مختلفة، السيطرة على الحدود مع تركيا، إذ إن معبر كسب تحت سيطرة دمشق من طرف اللاذقية، لكنه مقفل من الجانب التركي. ويخضع «باب الهوى» لسيطرة إدارة مدنية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على معظم إدلب، في حين يتبع «باب السلامة» لمنطقة أعزاز في محافظة حلب، ويقع تحت سيطرة فصائل «درع الفرات» التي تدعمها أنقرة، كما هو الحال مع معبر «جرابلس».
وكانت تل أبيض تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي طردت «داعش» في 2015. وفي أكتوبر 2019، أصبح تحت سيطرة فصائل سورية مدعومة من الجيش التركي، كما هو الحال مع مدينة رأس العين.
وعين العرب (كوباني) التي تقع شمال حلب كانت تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، ولكن دخلته في نهاية 2019 قوات الحكومة رمزياً، وانتشرت دوريات روسية قرب المدينة، وهو مغلق رسمياً. أما القامشلي – نصيبين، فهو مقفل، ولا يزال رمزياً تحت سيطرة قوات الحكومة التي تملك «مربعاً أمنياً» ومطاراً في المدينة.
– من طهران إلى دمشق
تضمن اتفاق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ودمشق نشر بضع مئات من الجنود السوريين على طول تلك الحدود، لكن «وجود هذه القوات كان رمزياً فقط. ومنذ ذلك الحين، انطلقت الدوريات الروسية باتجاه الشرق، في محاولة لإقامة موقع في مدينة المالكية (ديريك)، والسيطرة على المعبر مع العراق في سيمالكا – فيشخابور، وهو طريق الإمداد البري الوحيد المتاح للقوات الأميركية في شمال شرقي سوريا». كما هددت ميليشيات عراقية مراراً وتكراراً بالاستيلاء على فيشخابور.
ولا تزال المعابر الشمالية إلى تركيا كافة مغلقة، كما يمنع الجدار الحدودي أنشطة التهريب، ما جعل معبر سيمالكا – فيشخابور النافذة الدولية الوحيدة أمام «الإدارة الذاتية». وعلى الجانب العراقي من الحدود الشرقية لسوريا، كانت ميليشيات عراقية مسؤولة عن معظم المناطق منذ خريف 2017، عندما فقدت «حكومة إقليم كردستان» سيطرتها على الأراضي المتنازع عليها بين كركوك وسنجار، لكن لم تشمل هذه الأراضي المفقودة فيشخابور. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على الجانب السوري من الحدود، بدعم من القوات الأميركية. وأفاد التقرير: «لكن الوكلاء الإيرانيين منعوها، ومنعوا غيرها من الجهات الفاعلة، من استخدام أي معابر أخرى، وذلك جزئياً بمساعدة التعاون الدبلوماسي الروسي، إذ تم إغلاق معبر اليعربية الحدودي الرسمي أمام المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة منذ أن استخدمت روسيا حق النقض ضد تجديدها في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2019. ومن بين التداعيات الأخرى لهذا القرار أنه يجب أولاً إرسال جميع مساعدات الأمم المتحدة إلى (الإدارة الذاتية) بالكامل إلى دمشق، قبل أن يتم نقلها إلى الشمال الشرقي من البلاد».
وعليه، فإن الباحث الفرنسي يرى أن معبر سيمالكا – فيشخابور «يعد أمراً حيوياً للبقاء السياسي والاقتصادي للمنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي، حيث يمثل نقطة الدخول الوحيدة للمنظمات غير الحكومية الكثيرة التي تعمل فيها وتوفر دعماً أساسياً للسكان المحليين». ومع ذلك، لا تزال الحكومة السورية تعد الدخول عبر هذا المعبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات، و«من المحتمل أن يكون تعنت النظام بشأن القضايا الإنسانية هو طريقته لمحاولة إعادة تأكيد سيطرته على جانب واحد على الأقل من السيادة الحدودية».
ويقع عين ديوار تحت سيطرة «قسد»، ومعبر زاخو يستعمل للعبور إلى كردستان العراق، فيما يخضع اليعربية – الربيعة لـ«قسد»، في وقت يقع فيه معبر البوكمال – القائم تحت سيطرة قوات الحكومة وميليشيات إيرانية، وقد جرى تدشينه بعمل بين سوريا والعراق في خريف 2019. وتسيطر قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا على معبر التنف – الوليد منذ طرد تنظيم داعش. ويقول دبلوماسيون غربيون إن أميركا سيطرت على التنف لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، وإن إيران ردت على ذلك بفتح طريق مواز عبر البوكمال.
– أجواء مفتوحة
وفي مقابل محدودية السيطرة على الحدود ومعابرها، فإن الحكومة تملك النفوذ على الموانئ البحرية والمطارات، بما فيها مطار القامشلي في مناطق الأكراد شرق نهر الفرات، علماً بأن التحالف الدولي أقام شرق الفرات عدداً من القواعد العسكرية التي تسمح له باستخدامها لهبوط وإقلاع وإقامة طائرات مروحية وشاحنة شرق نهر الفرات. كما حولت روسيا مطار القامشلي إلى قاعدة عسكرية لها.
ورغم وجود منظومات صواريخ «إس-300» و«إس-300 متطور» و«إس-400» تابعة للجيش الروسي الذي يملك قاعدتين في طرطوس واللاذقية، لا تزال الأجواء السورية «مفتوحة» أمام التحالف الدولي والطائرات الإسرائيلية التي شنت مئات الغارات على «مواقع إيرانية» في سوريا.
وإذ يعلن مسؤولون سوريون، واللاعبون الدوليون والإقليميون، بشكل دائم «التمسك بالسيادة» ووحدة البلاد، وأن مناطق النفوذ «مؤقتة، وليست دائمة»، فإن «التوازنات» بين خمسة جيوش، روسيا وأميركا وتركيا وإيران وإسرائيل، والتفاهمات بين أميركا وروسيا شرق الفرات، وبين روسيا وإيران وتركيا في «صيغة آستانة» في شمالها، تجعل الرغبات الرسمية السورية خاضعة للعبة دولية – إقليمية تحد -إلى الآن- من تحقيق «السيادة الكاملة»، وترجمة التصريحات إلى واقع ملموس.
الشرق الأوسط
مخيمات الشمال السوري منكوبة والمدارس مدمرة والمعارضة منشغلة بخلافاتها
يعاني الشمال السوري من أوضاع إنسانية متدهورة وأزمات كبرى تحاصر مئات آلاف السوريين، جراء العواصف والأمطار من جهة، وتصاعد مستويات البطالة من جهة أخرى، وتقلص الدعم المقدم من الجهات المانحة، وسط أزمات تعليمية وخدمية أخرى باتت تهدد حاضر المنطقة ومستقبلها خاصة على المستوى التعليمي. إذ تشير الإحصائيات إلى تسرب عشرات الآلاف من الأطفال خارج العملية التعليمية والتوجه نحو سوق العمل جراء الأزمات الاقتصادية، في حين تبدو المعارضة السورية الحاضر الغائب في واقع مأساوي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لإعادة الحياة للملايين من النازحين السوريين داخل المخيمات وداخلها.
فريق منسقو الاستجابة، الذي أعلن مؤخرا كافة مخيمات الشمال السوري «مناطق منكوبة» جراء العواصف والأمطار، اعتبر أن المخيمات تحولت إلى قصص من مأساة الشعب السوري، حيث تحولت كل خيمة، إلى قصة تعود لعائلة هجرها النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني، إذ لم يبق لهم من وطنهم الأم سوى قطعة قماش عجزت عن حمايتهم من البرد والصقيع.
وأشار الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إلى أن الأمطار والسيول أدت إلى تضرر 283 مخيما في الشمال السوري مؤخرا، في حين أن 4000 خيمة تدمرت بفعل العوامل الجوية، وباتت 3800 عائلة بدون أي مأوى.
الحرب والنزوح
لا بد من وجود عوامل أخرى أثرت في تفاقم معاناة الشعب السوري في المخيمات وخارجها، غير التي تسببت بها العوامل الطبيعية.
ويقول الباحث السياسي رشيد الحوراني، لـ «القدس العربي» إن «هناك عوامل تضاف للطبيعة في أزمات الشمال السوري، منها عدم كفاية الدعم المقدم الذي من شأنه تخفيف المعاناة، إذ أن المساعدات يجري التعامل معها كورقة للضغط السياسي، ومحاولات روسيا عبر المؤسسات الدولية وسعيها لحصر تقديم المساعدات عبر المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري. وبالتالي تشكيل ضغط مادي ومعنوي على تركيا، في حين أن المنظمات المحلية لا تسعى لتقديم خدماتها بشكل يحقق التكامل فيما بينها».
الأسباب عديدة ومعقدة من وجهة نظر الباحث في مركز الحوار السوري محمد سالم، يمكن تلخيصها وفق ما قاله لـ «القدس العربي» بظروف الحرب والنزوح التي أدت إلى ازدياد الحاجات الإنسانية بشكل كبير، وهو أمر طبيعي في هكذا حال. وبحسب المختصين بتقدير الاحتياجات، فإن المخصصات للدعم الإنساني لا تفي أبداً بالاحتياجات الموجودة واقعياً، وبالتالي هناك نقص في الدعم اللازم.
يضاف إلى ذلك، الأخطاء أو سوء الإدارة في تنفيذ برامج الإغاثة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية، إضافة إلى ضعف أداء الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ.
السياسي السوري درويش خليفة، فذهب معتقدا أن تقليص الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، عامل مهم جدا في تعقيد الأوضاع الإنسانية للسوريين في المخيمات على وجه التحديد.
كما أن وباء كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية، وعدم إلتزام الجهات المانحة بتقديم الدعم، كلها عوامل شاهد الجميع نتائجها المؤلمة في الأسابيع الأخيرة في المخيمات التي تحتوي قرابة مليوني إنسان سوري خسروا أملاكهم ومنازلهم وهجرهم النظام والدول الراعية له.
المخيمات مقابر جماعية
أعلن فريق منسقو استجابة سوريا كافة المخيمات الموجودة في محافظة إدلب وريفها ومناطق ريف حلب، مناطق منكوبة بالكامل، وطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لإغاثة المنكوبين والوقوف على احتياجاتهم وتلبية خدماتهم الأساسية وتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المنطقة. مشيرا إلى تضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات، وتعطل حركة الطرقات المؤدية إلى المخيمات أو داخلها وتهدم المئات من الخيام وتضرر الآلاف الأخرى وتحول تلك المخيمات إلى مقابر جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مع ضعف كبير في الخدمات والامكانيات المتاحة وعدم توفر مراكز إيواء لاستيعاب آلاف المتضررين.
في حين أشار الدفاع المدني السوري إلى أن موجات البرد والصقيع التي يشهدها الشمال السوري واستخدام مواد في التدفئة غير صحية، كلها عوامل أدت إلى تردي أوضاع المدنيين، وازدياد الأمراض التنفسية وتتضاعف حاجة الأطفال للرعاية الطبية، وعبد الكريم أحد هؤلاء الأطفال أصيب بالتهاب قصبات حاد.
واقع مرعب
الأطفال، وهم الحلقة الأهم، فيعاني الآلاف منهم من مستقبل مجهول، بعد أصبحوا متسربين خارج فصول الدراسة نتيجة الزواج المبكر وارغامهم على العمالة بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة في المنطقة.
وتبدو العملية التعليمية في الشمال في هكذا واقع رغم جهود الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة في هذا الإطار صعبة للغاية. إذ أشار فريق منسقو الاستجابة إلى أن أكثر من 450 ألف طالب يواجهون مصاعب مختلفة لإكمال تعليمهم بينهم 60 ألف طالب ضمن المخيمات.
إضافة إلى تهدم مئات المدارس وتضررها بدرجات متفاوتة، علاوة عن ذلك، فقد أصبح الحصول على الكتب المدرسية حلماً بعيد المنال للأطفال في المراحل الدراسية.
غياب النظام السياسي
يعد الاستقرار السياسي عاملا مهما من عوامل التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، لكن لا يعني هذا أن تصل الأحوال الإنسانية إلى ما آلت إليه في الشمال السوري، ومن دون وجود بقعة ضوء في هذا النفق المعتم.
ويمكن استثمار هذه الحالة، بحسب الباحث رشيد حوراني لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية، فالنظام السوري على سبيل المثال خاطب المجتمع الدولي عن طريق مجموعة من رجال الدين المسيحي ليبينوا الآثار الاجتماعية التي وقعت جراء قانون قيصر، ولقي ذلك صدى في المجتمع الدولي، لكن يمكن القول إن ضعف الخبرة السياسية لدى مسؤولي المعارضة يجعل هذه الحالة بكائية.
أما الباحث في مركز الحوار السوري محمد سالم، فقال لـ «القدس العربي»: الاستقرار الأمني والسياسي مطلوب لتحقيق أي تحسين للأوضاع الإنسانية، لا يمكن تنشيط التعافي المبكر، والانتقال من حالة الإغاثة إلى حالة التنمية بشكل تدريجي من دون حدوث استقرار نسبي، وتوقف تهديدات النظام والروس باجتياح إدلب. إضافة إلى ازدياد نسبة التفجيرات في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، فضلاً عن ضعف أداء الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ لأسباب عديدة موضوعية وذاتية.
أين المعارضة؟
السياسي السوري درويش خليفة، رأى خلال تصريحات أدلى بها لـ «القدس العربي» أن المعارضة السورية شبه منفصلة عن الواقع المحلي خاصة الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا، معللا ذلك بأنها منشغلة بحل خلافاتها الداخلية والتواصل مع الجهات الدولية.
كما اعتبر أن المعاناة ستبقى تحاصر السوريين في المخيمات حتى تشهد البلاد عملية انتقال سياسي وبيئة آمنة، تبدأ معها عودة تدريجية للحياة المدنية.
ونقل المصدر معلومات من مقربين من الإدارة الأمريكية، أن الأخيرة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لتجهيز عدة مشاريع وبرامج لتقديم مساعدات للسوريين في الشمال الغربي من البلاد، بما فيها المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وكذلك شرق الفرات الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، منوها إلى أن الدعم الأمريكي المرتقب سيكون على مستويات جيدة.
وأكد على أن الوضع يتدهور تدريجيا والمتوقع تفاقمه أيضا، إلا فيما لو تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لتقديم دعم إنساني وصحي للسوريين في الشمال، في حين أن المسار السياسي يبقى مجهولا وبانتظار المنهجية التي ستعتمدها واشنطن للتعامل مع الملف السوري، خاصة بعد ربطه بالملف النووي الإيراني.
غياب المجتمع الدولي
تعود أسباب تراخي المجتمع الدولي، حسب الباحث رشيد حوراني، لاستخدام ملف الشمال كورقة ضغط على تركيا وتحقيق تبدل في موقفها.
إلا ان تركيا بدأت التخلص من هذه الورقة الضاغطة عليها تدريجيا من خلال البدء بإعمار مساكن من الأسمنت وإسكان المهجرين فيها، وبدأت بالشرائح ذات الضرورة الأكثر إلحاحا كالأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر الباحث محمد سالم، أن طول الأزمة السورية وحدوث أزمات أخرى في العالم، كاليمنية والخليجية، أضعفت استجابة الداعمين للملف الإنساني السوري.
كما أسهم في ذلك أيضاً ضعف وتشتت المعارضة الرسمية، وعدم قدرتها على بناء أجسام إدارية وتمثيلية حقيقية، فالائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة هياكل إدارية وتمثيلية ضعيفة الشرعية.
ما الحلول؟
تعددت رؤى المصادر البحثية في الحلول التي يحتاجها الشمال السوري حتى يعود للحياة، فرأى الباحث رشيد الحوراني، أن المنطقة تحتاج إلى إجراء مسح شامل لكافة المشاكل التي يعاني منها تقوم به المنظمات المحلية فيما بينها، وترتيب المشاكل المطروحة وفق أولويات تلافيها. ومن ثم دراسة إمكانية إنشاء المشاريع التنموية التي تحتاج لرأس مال بسيط ودورة اقتصادية سريعة تشجع المستثمر على الاستثمار في المنطقة. وكذلك التعاون مع الجانب التركي في تصريف الإنتاج خاصة ان تركيا استوردت عددا من المحاصيل المنتجة في الداخل السوري كالبطاطا، والأهم من كل ذلك تحقيق الأمن الذي من شأنه تشجيع الاستثمار.
أما الباحث محمد سالم، فأشار إلى أن الأولويات اليوم تتجه نحو ضرورة تحقيق استقرار طويل الأمد، من خلال ضمان دولي بعدم اجتياح الروس والنظام للمناطق المحررة، وقد انعكس الاستقرار النسبي منذ توقيع اتفاق موسكو بشكل إيجابي على المنطقة، فبدأنا نشهد ملامح استقرار على الرغم من الصعوبات الكثيرة.
كما لا بد من ضبط الوضع الأمني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وتشديد العقوبات ومنع تكرار التفجيرات العشوائية، بعد ذلك، يمكن أن تتوجه أموال المانحين تدريجياً إلى دعم ما يسمى بالتعافي المبكر، والذي يعني الانتقال التدريجي من مجرد إغاثة اللاجئين والنازحين إلى محاولة إيجاد أعمال لائقة لهم وضخ الانتعاش الاقتصادي في الشمال المحرر.
في حين أن السياسي درويش خليفة، رأى أن الحلول السياسية في سوريا ومن ضمنها بطبيعة الحال الشمال، لن تحل على مستوى المعارضة، بل عبر تطبيق القرارات الدولية تجاه الملف السوري كالقرار 2254 والانتقال السياسي والبيئة الآمنة وإخراج المعتقلين من سجون النظام، فالسوريون بحاجة لاستقرار سياسي حتى يستطيعوا العودة إلى الحياة الطبيعية، خاصة أن الوضع الاقتصادي في البلاد متدهور للغاية وسط نسب مرتفعة وغير مسبوقة من البطالة في حين المرتبات الشهرية لا تكفي سوى لبضعة أيام فقط.
أما على المستوى المحلي، فينبغي تقديم الخدمات للسوريين، ودعم الزراعة وتشجيعهم عليها، وتأمين فرص عمل ولو بالحد الأدنى، وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة، وتقديم المساندة من قبل دول الجوار السوري، خاصة مع وجود مساحات كبيرة صالحة لنمو الثروة الزراعية، وبالتالي تحقيق جزء بسيط من الدعم الذاتي للسوريين، وغيرها العديد من المشاريع الاقتصادية.
القدس العربي»