كتابات النفَس القصير/ عدي الزعبي, صلاح باديس
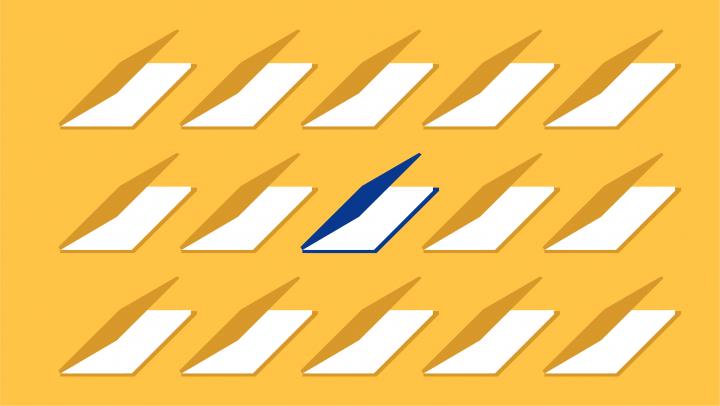
تسود أشكال محددة في الكتابة العربية، وتنتشر لتغطي على أشكال أخرى. نريد لكتابات مختلفة أن تُقرأ. نريد ألا يحكمنا التشابه الأبيض. لذا، نقدّم هنا مجموعة من النصوص الأدبية، تسعى إلى قول مختلف.
الكتابة السائدة كتابة روائية طويلة؛ أحيانًا ناجحة جدًا، وأحيانًا مكررة مملة بشكلها السياسوي أو التاريخي أو الوعظي أو الواقعي الذي يريد أن يكون مرآة أو الفانتازي الذي يسعى إلى الإبهار. تُهمّش كتابات تتسم بنفس أقصر، ومركّز أكثر من حيث الحجم، ومتنوع أكثر من حيث المضمون؛ كتابات غالبًا تدور حول خبرات الكاتب الشخصية وحياته الحقة وغير معنيّة بالخيال المجنّح، أو توظّف الخيال في اليومي والعادي: كتابات القصة القصيرة والمقال الأدبي التي ما زال كثيرون يرون فيها نوعًا ثانويًا من الكتابة، بل وربما هامشيًا، لا ترقى لمستوى العمل الطويل المتشعب التفصيلي.
على العكس تمامًا، نعتقد أن هذه الكتابات تستحق مكانةً خاصة، ليس فقط لأنها تخالف السائد؛ بل لأنها، وبشكل رئيس، أعمال أدبية صادقة، تعكس العالم الذي نعيش فيه، ونفوس كتّابها، بطريقة مبتكرة وأصيلة؛ ولا تتبنى وصفات جاهزة للكتابة؛ ولا تغرق بالضرورة في الأحداث المباشرة المعاصرة؛ لتُفسِحُ مساحة لسؤال وحيرة الكتابة في جوهرها.
لذا، نقدّم هنا مشروعًا مشتركًا بين مجموعة من الكتاب والكاتبات في جنس المقال الأدبي، وهو مصطلح غامض قليل ربما، ويتفلت من التصنيف المدرسي البسيط: يتقاطع مع المقال الصحفي أحيانًا، ويقترب من القصة القصيرة أحيانًا أخرى، ويكاد يتطابق مع قصيدة النثر في بعض الحالات. نتشارك مع الكتّاب في الرغبة بأن يُقرأ المختلف ويؤخذ بجدية؛ لا تجمعنا رؤية أدبية مكتملة ولا فلسفة موحدة صارمة، ولكن يجمعنا الاحتفاء بالكتابة المختلفة، بطرق متعددة.
تبحث المقالات الأدبية المشاركة هنا في فكرة الكتابة ذاتها، من زوايا مختلفة. يعالج كل مقال موضوعه بطريقته الخاصة، ويحث القارئ على التفكر في فعل الكتابة بظاهره وباطنه.
الأسماء المشاركة قد تكون قليلة، ونعلم جيدًا أن هناك عشرات الكتّاب الذين يشاركوننا رؤيتنا، ونرغب بالتواصل معهم والاستماع إليهم والتعلم منهم. الملف هذا محاولة أولى للقيام بفعل أدبي مشترك يعبّر عن الكتابة المختلفة. نأمل أن يتبعه محاولات أخرى، تكسر الجمود الطويل المخيم علينا جميعًا.
——————
هيثم الورداني: للموتى لمَن لم يولدوا بعد
“أين تقع الكتابة؟ يخبرنا السهروردي أن هناك بلادًا تلي أقاليم الدنيا السبعة وتسبق ملكوت الأرواح. بلاد تقع خلف جبل قاف، آخر حدود العالم المحسوس. هذه البلاد يسميها السهروردي ناكُجا آباد، وهو تعبير غير مألوف في اللغة الفارسية”…
للموتى لمَن لم يولدوا بعد/ هيثم الورداني
هل القراءة فعل فردي؟ قراءة حدث مثلًا، أو قراءة مصير، أو قراءة أرشيف. لكن أيضا قراءة كتاب، أو قراءة قصيدة، أو قراءة رواية.
هل من يقوم بكل هذه الأشكال المختلفة من القراءة هو الفرد؟ قد يمكن صياغة أحد شعارات التسعينيات غير المكتوبة آنذاك على النحو التالي: إما الفردية وإما الأيدولوجيا. أي أن التمسك بالحس الفردي هو وحده ما ظننا أنه يعصمنا من الإيدولوجيا. وفي اللحظة التي ينفلت خيط الفردية من بين أيدينا ستتخطفنا الأيدولوجيات والهويات. فعل القراءة وفقا لهذا الارتياب التسعيني الأصيل يعني ضرورة الانطلاق من أسئلة فردية، وإلا تحوّل إلى قراءة أيدولوجية تَعمَى عن ما تحاول قراءته. لم يكن هذا الشعار غنائيا، بل كان يرد على متطلبات لحظة تاريخية معينة، لكن الزمن قد تجاوزه بالتأكيد، وأضحى بحاجة ماسة إلى مراجعة جذرية. فالفردية نفسها يمكن أن تصبح أيدولوجيا، بل هي أيدولوجية الليبرالية الجديدة بامتياز. هي نوع خبيث من الأيدولوجيا يتمثل في تحوّر اللا أيدولوجيا نفسها إلى أيدولوجيا شفافة، لتصبح أكثر أنواع الأيدولوجيات ضررًا.
لكن لنعد إلى فعل القراءة. هناك ذاتية تتشكل بلا جدال في فعل القراءة، مثلما أن هناك ذاتية تتشكل في فعل الكتابة، لكن الأكيد أن لا القراءة ولا الكتابة هي أعمال فردية، ولا حتى جماعية. الذاتية الفاعلة في فعل القراءة هي نتيجة وليست نقطة بداية. تنمو وتتشكل عبر تعقيدات وانكسارات موضوعها، وليس خارجه. نحن لا نبدأ القراءة بذوات مكتملة، ونسير معها ومع تقلباتها مطمئنين إلى أننا لن نسقط في فخ الأيدولوجيا، ما دامت اهتماماتنا وأسئلتنا تنطلق من المنظور الفردي. بل نحن نصل إلى هذه الذاتية عبر فعل القراءة، أو بالأحرى ننتجها عبره إنتاجًا. غير أن ما نصل إليه ليس ذاتًا فردية يمكن أن تخص شخصًا أو حتى جماعة، ما نصل إليه هو ذات غير فردية، وغير منطبقة على نفسها. القراءة ليست تأويلًا حرًا للواقع، ولا توثيقًا لسيرة المعرفة في طريق إحكام قبضتها على مادة بحثها.
القراءة هي عملية أشد راديكالية لأنها عملية إنتاج لذاتية متناقضة، غير فردية، وغير جماعية، بل وغير إنسانية أصلًا، لأنها لا تنفصم البتّة عن الموضوعية التي تسري فيها. هي تحديدًا مواطن خلل هذه الموضوعية، ونقاط تصدعاتها الجدلية، أي النقاط التي يمكن فيها أن تنكسر وتتغير. ما قد يحمي إذن من الأيدولوجيا ليس إعادة تنظيم الواقع وفقًا لمبدأ آخر مهيمن، الفردية على سبيل المثال، وإنما العمل الشاق لتلمّس شقوق هذا الواقع. والقراءة ما هي إلا برنامج عمل لتفعيل أو إنتاج مثل هذه الشقوق والتصدعات.
علم النسيان
تأتي الكتابة دوما ومعها أكثر مما وُضِع فيها. فهي تفيض عن نفسها، وتحمل معها شيئا آخر غير ما كان يصبو إليه من كتبوها. هذا الفائض الذي تُنتجه الكتابة، يجعلها لا تستقر في أي تعريف محدد لوظيفتها. فهي تنتج ما يفيض عن كونها توصيلًا لمعنى، أو تحقيقًا لفكرة، أو توثيقًا لسيرة، أو غيرها من الوظائف الممكنة. حتى الكتابة التي تفهم نفسها بوصفها كتابة حُرة ومُنزهة عن أية أغراض تُنتج هي الأخرى ما يفيض عن تلك الحرية المجردة. الكتابة بهذا المعنى تمتص أي غاية خارجية، أو أي فكرة مسبقة عنها، حدَّ تجاوزها.
بكلمات أخرى، الكتابة الحقيقية هي ما يحدث من وراء ظهر الكتابة. وهذا الفائض الذي يحدث من وراء ظهر الكتابة هو ما تنتجه وهي تظن أنها تحقق ما تصبو إليه، بينما هي في الحقيقة تقع في تناقضات غايتها، لكنها لا تعرف ذلك بعد. وعندما تعرف ذلك ستفهم أن ما نكتبه لا يمكن أن يظهر حقًا سوى في ثنايا تناقضات الكتابة، وليس في الصورة الكلية التي تسعى الكتابة لرسمها له. لنأخذ على سبيل المثال حالة مؤرخ يسرد أحداثًا ووقائع وهو يظن أنه بذلك يرسم ملامح مكتملة لروح العصر الذي يبحث فيه، لكن هذا الروح لا يختبأ تحت طبقات الأحداث التاريخية في انتظار أن تكشفه كتابة المؤرخ فتكتمل مهمتها، وإنما هو مبثوث في تناقضات كتابة تلك الأحداث التي لا يمكن حلها نهائيًا. روح العصر الذي يريد المؤرخ معرفته لا يتجلى عبر الكتابة، كأنه منفصل عنها، وإنما هو شقوق تلك الكتابة نفسها، وهو ما لا يعرفه المؤرخ بعد.
لذلك لا يمكن لكتابة حقيقية أن تقترب من موضوعها، إلا عندما تنسى نفسها، وتترك نفسها تغرق في تفاصيل ما تسرده، وتناقضاته التي لا تنتهي، على أمل أن تعود وتتذكر نفسها، فترى أنقاضها، وتدرك أن المعرفة التي تبحث عنها لا توجد سوى في التناقضات التي تنتجها. روح العصر الماضي، الذي تبحث عنه كتابة المؤرخ، لا يوجد سوى في تلك المسافة التي شقتها الكتابة، عبر تناقضاتها، في روح عصرها هيّ، أو بالأحرى هو بالضبط تلك المسافة. لكي تفيض الكتابة عن نفسها إذن لابد أن تنسى نفسها قليلًا، حتى يمكنها فيما بعد أن تتذكر نفسها. ولأن النسيان هيهات أن يخضع للإرادة الواعية، فإنه يستحيل تقريره مسبقًا قبل الشروع في عملية الكتابة. هو قد يحدث، أو لا يحدث.
وبالتالي لا يمكن للكتابة أن تتنبأ أبدًا بفائضها. عليها فحسب أن تكتب وتكتب وتكتب، حتى يحدث، وقد لا يحدث، أن تتذكر نفسها، فتنتبه متأخرة إلى التناقض الجوهري بين ما تكتبه، وبين ما كانت تظن نفسها أنها تكتبه، لتدرك ضرورته بأثر رجعي. الكتابة بهذا المعنى لا تصوغ معرفة مسبقة في كلمات وجمل مناسبة، وإنما هي تمارس ما لا تعرفه بعد، لأن كل ما سبق لها معرفته لا يكفي أبدًا، ولابد أن تنساه لكي تكون كتابة حقيقية. هذا الذي لا تعرفه الكتابة بعد، بينما هي تمارسه بالفعل، هو فائضها، هو استحالتها، هو عدم انصياع موضوعها لها، هو تناقضها مع نفسها. الكتابة هي معرفة مؤجلة دومًا، ولا يمكن مراكمتها. تنسى نفسها، ثم تعود وتتذكر، لتعرف نفسها بأثر رجعي. ولا يمكنها أن تعرف نفسها سوى هناك حيث تفيض عن نفسها.
ضدّ
قصيدة ضدّ من لـأمل دنقل هي إحدى قصائده المتأخرة، التي ضمها ديوانه الأخير أوراق الغرفة رقم 8. والغرفة المعنية هي، كما هو معروف، غرفة معهد الأورام التي انتقل إليها بعد إصابته بالسرطان، وتوفي فيها عام 1983. القصيدة قصيرة، من ثلاثة مقاطع. تبدأ بمقطع عن هيمنة اللون الأبيض على كل تفاصيل المستشفى، واختناق الشاعر تحت وطأته، ثم تساؤله إذا ما كان سبب ارتداء المعزين للون الأسود يرجع لكونه هو لون النجاة من الموت. وتنتهي القصيدة بمقطع عن توزّع حياة الشاعر بين اللونين الأبيض والأسود، ولون ثالث، هو لون الحقيقة الذي يراه في عيون أصدقائه العميقة، ويصفه بأنه لون تراب الوطن. وبين المقطعين يأتي المقطع القصير التالي، والذي يستحق التوقف عنده قليلا:
ضِدُّ منْ؟
ومتى القلبُ – في الخَفَقَانِ – اطمأَنْ؟
تُرى ما المقصود بالسؤال الأول؟ وهل يعود على طرف بعينه أم على علاقة تضاد؟ ربما يكون من المفيد النظر في الأسطر الأخيرة من المقطع السابق. سنجدها تتساءل عن سبب اتشاح المعزين باللون الأسود، وتقول:
هل لأن السواد،
هو لون النجاة من الموت،
لون التميمة ضدّ الزمن؟
هل يتصل التضاد في المقطع الثاني إذن بالتضاد الذي ينتهي به المقطع الأول؟ بمعنى، هل يتقدم الشاعر هنا بسؤاله خطوة تالية وكأنه يقول: ضد من يحتجّ السواد؟ ضد الزمن أم ضد اللون الأبيض المتجانس أم ضد المرض؟ هل سؤال “ضد من؟” بهذا المعنى هو سؤال بلاغي، أقرب إلى كونه كناية عن الكثرة أو عن تعدد الأطراف التي يجب الاحتجاج ضدها؟ أي: ضد من أم من أم من؟ أم لعل السؤال هو سؤال استفهامي، يستعلم عن علاقة تضاد أخرى غير تضاد السواد مع البياض؟ علاقة تضاد لها أطراف أخرى ينبغي الاحتجاج عليها غير الموت؟ لكن ما هي علاقة التضاد الأخرى هذه؟ لا يخبرنا الشاعر.
كل ما يمكننا التفكير فيه، هو أن السؤال الآن لم يعد يقتصر على تحديد الطرف الذي تحتجّ القصيدة عليه فحسب، بل أضحى يشير أيضًا إلى علاقة التضاد نفسها التي تُنتج المواقفَ المتصارعة والمتضادة. أي أن تسمية طرف بعينه لم يعد الهدف الوحيد للسؤال، فهناك ما هو أهم، ألا وهو الشرط الاجتماعي؟ الذي يُنتج الأطراف التي تحتج القصيدة عليها.
لا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين، ولا يمكن حتى الاطمئنان إلى غياب احتمالات أخرى ممكنة للسؤال، فالشاعر يكتفي بصيغته المقتضبة والمكثفة للغاية، إلى أن يكاد السؤال يتوقف عن أن يكون سؤالًا، ويستحيل إلى صرخة قوية، تظل تتردد في جنبات القصيدة. صرخة يختلط فيها الاحتجاج ضد الموت بالاحتجاج ضد الشرط الاجتماعي المهيمن. صرخة تفيض عن كل المعاني التي نحاول تسكينها فيها.
لم يفهم دنقل القصيدة السياسية أبدًا بوصفها جنسًا أدبيًا خالصًا. فبالنسبة له لا توجد سوى قصيدة واحدة. هذه القصيدة قد تحمل رؤية اجتماعية، وسياسية، وطبقية، وشخصية. وقد تسكنها لحظات وجودية، وأخرى تاريخية، وثالثة شخصية. لكن لا يمكن الفصل ما بين كل هذه اللحظات والمستويات. القصيدة التي بين أيدينا هي مثال جيد على تلك الوحدة الشعرية المقترحة. فهي تبدأ بمقطع شخصي وجودي، وتنتهي بما يمكن وصفه بموقف اجتماعي سياسي متمثل بفكرة الوطن وترابه. ولنترك جانبًا الآن الغنائية التي يجلبها ربط السياسة بتراب الوطن، ولنبقى مع ملاحظتنا الأساسية حول القصيدة، وهي أن علاقة التضاد المبثوثة فيها هي علاقة يتحد فيها الجمالي بالسياسي. علاقة التضاد هذه تتصل أيضًا بالطريقة التي يفهم بها دنقل عمل الشاعر.
فهو يرى أن عمل الشاعر يتمثل في الأساس في الرفض. لكن الرفض هنا له معنى أكثر جذرية من المعارضة السياسية التقليدية. فالشاعر ليس معارضًا سياسيًا بالمعنى البسيط والمتمثل في تدبيج الشعارات، فهذا هو الشاعر الذي يُنكره دنقل، والذي يكتب قصائد سياسية. وإنما الشاعر الذي يبحث عنه دنقل هو من يرفض الواقع بوضعه القائم، بكل سياساته وجمالياته المهيمنة، ويكتب قصيدة لا ينفصل فيها السياسي عن الجمالي.
لنعد الآن إلى المقطع الثاني في قصيدتنا، ونقرأ السطر الأخير المدهش في هذا المقطع: ومتى القلب – في الخفقان – اطمأن؟ مرة أخرى نقف أمام سؤال. لكنه هذه المرة سؤال استنكاري واضح. فالمعنى المقصود هو نفي أن يكون القلب قد اطمأن يومًا وتوقف عن الاحتجاج. أي أن كل نبضة، وكل خفقة هي صرخة احتجاج، أو تعبير عن احتجاج لا تنتهي أسبابه. الحياة بهذا المعنى هي الخفقان الذي يكسر الاطمئنان، ويعكر صفو اللون الأبيض القاتل. لا يوجد وصف أبلغ من هذا السؤال لعمل النفي. فالنفي وفقًا له موجود حتى في خفقة القلب. كل نبضة هي نبضة تضاد، هي خفقة تنفي وتحتج وتسعى إلى التغيير. وهنا لا يسعنا سوى أن نستعيد أصداء السؤال الأول، “ضدّ من؟”، فنسمع في خفقان القلب صرخة احتجاج ضد كل الشروط المهيمنة وما تفرزه. السؤال الثاني يلد السؤال الأول من جديد. فتصبح كل خفقة، كل نفَس، كل نبضة صرخة احتجاج لا يمكن تسكينها في خبر متعين. تصبح ضدًّا خالصًا. نفيًا خالصًا.
قصيدة دنقل هي قصيدة عن التضاد، لكن شتان بين التضاد الذي تتحدث عنه القصيدة، وذلك التضاد الميت والمحايد. الأبيض والأسود هنا، وهما المثال التقليدي للتضاد المحايد، المنعدم التبعات، أصبحا الآن جزءًا من تضاد أبلغ، وله تبعات. الأبيض والأسود لم يعودا مجرد لونان متضادان من الخارج، وإنما أضحيا مجالًا مغناطيسيًا متوترًا، تقدح فيه شرارة الرفض، ويقود إلى سؤال الحقيقة. قد يكون ما تقوله لنا القصيدة هو أن علاقة التضاد سابقة على الأطراف المتضادة، بل وقد تكون مؤسِّسَة لها. قد يكون ما تقوله لنا هو أن علاقة التضاد لا تحتاج إلى سبب خارجي لكي تتوجه بالاحتجاج ضده. فالحياة هي احتجاج متواصل ضد نفسها، هي مراجعة مستمرة لعلاقاتها الحاكمة، ورفض موجه ضد وضعها القائم. حتى الحياة العارية، المحفوظة في غرف المستشفيات، والمدارة من قبل الأطقم الطبية، لا تقع خارج علاقات التضاد والنفي. فهي تستند إلى قلق أو تناقض أساسي، لا يمكن تسكينه، ولا يمكن حله حلًا نهائيا. القلب الذي يخفق بالحياة العارية هو لا طمأنينة أولية وليس مجرد إشارة تثبت الحياة. ما تقوله لنا القصيدة هو أن خفقان القلب لا يقبل الحياة كما هي، بل يحتج ضدها، يثبتها وينفيها معا، يكسر استمراريتها المتجانسة بلاطمأنينته الضرورية. ولعل التقاط هذه الخفقان الساري في الأشياء هو عمل الشاعر كما فهمه دنقل.
الحقيقة
كنت جالسًا في غرفتي، أقلّب الجمل يمينًا ويسارًا، ثم أعيدها إلى ما كانت عليه، عندما دخل عليّ وليد طه. وقف في وسط الغرفة ينظر إليّ، ولم ينبس بحرف. ثم انهارت فجأة قوائمه، وأقعى على الأرض. كنت قد توقفت عن الكلام مع البشر الفانين في ذلك الوقت، وأصبحت أتكلم فقط مع الموتى، ومع من لم يولدوا بعد. أذهب كل يوم إلى العالم السفلي، وأعود والدماء تعلو ملابسي، ثم أجلس لأكتب ما رأيته. لكن مهمتي لم تكن سهلة. إذ كيف يمكن منح صوت لمن لم يعد له لسان؟ كيف يمكن استعادة كل رهانات الماضي الخاسرة؟ كيف يمكن تعويض الأثمان الباهظة التي دُفعت من أجلها؟ وكيف يمكن تمرير كل تلك الخبرة لمن سيرثون جراح الماضي التي لا تلتئم، دون أن يعرفوا أسبابها؟ يومًا وراء يوم يتأكد حدسي أن الفانين حولي ليسوا سوى أرواح ميتة، أسيرة لحظتها الراهنة، ولا تبصر ما هو خارجها.
ويومًا وراء يوم يزداد شقائي تحت وطأة مهمتي الصعبة. فأراوح مكاني. أغضب تارة، وأعظ في الناس تارة أخرى. إلى أن دخل غرفتي وليد طه في ذلك اليوم، فوجدت نفسي أترك كل ما بيدي جانبًا. في تلك الأيام التي تشاركنا فيها الغرفة لم أكن أستطيع الكتابة. كنا نتبادل النظرات الجانبية الخاطفة، ونتحاشى النظرات المباشرة. وأضحت غرفتي جُحرًا غارقًا في الصمت، نتبادل الاستلقاء في أركانه دون أن يقترب أحدنا من الآخر. حتى نهض وليد طه ذات يوم فتبعته. وفي رحلتنا تلك بقي هو على حاله صامتًا، في حين بدأت أنا أتعلم الكلام من جديد. ما تعلمته منه هو أن أكف عن الصدق، وأن أقول الحقيقة.
الكتابة الصادقة هي كتابة تظن أن بإمكانها أن تمسك بالواقع وتصوّره كما هو عليه. كتابة مرت بخبرة فارقة، وتريد كتابتها كما وقعت. لكن ما تتعلمه الكتابة عبر أكثر الطرق وعورة هو أن الخبرة لا تنفصل عن كتابتها. الخبرة لا تحدث أولا، ثم تأتي الكتابة لكي تصورها كما حدثت. بل الكتابة هي ما يجعل تلك الخبرة المُعاشة خبرة بالأساس، لأنها تخلق ضرورتها بعد أن كانت حدثًا طارئًا. الكتابة تريد أن تقول شيئًا عن خبرة متفردة، فتقع في تناقض بين خصوصية الخبرة وعمومية اللغة، وما أن تتجاوز هذا التناقض، حتى تقع في تناقض بين حاضر الخبرة وتاريخها. وهكذا، تسير الكتابة من تناقض إلى تناقض، وما بينهما توسّط. لتكتشف أن الخبرة التي تسعى إلى الإمساك بها لا تعيش سوى في لحظات تناقضها مع نفسها تلك، وتوسّط اللغة فيما بينها، وهذه حقيقة الخبرة التي لا يمكن معرفتها من دون اللغة.
على الكتابة إذن أن تجرب أن تقول ذلك عن الخبرة، أي أن تقول حقيقتها، باختصار أن تقول الحقيقة. لكن الحقيقة هنا ليست مضمونًا، وليست موجودة سلفًا، والأهم أنها لا يمكن أن تنفصل عن فعل قولها، ولا مكان لها خارجه. الحقيقة هي تحديدًا عمل اللغة المضني، وليست ما يمكن تمريره عبر اللغة. عملها الذي يسير بها من تناقض إلى آخر.
أن نقول يعني أن نخرج عن ذواتنا ونضع أنفسنا قيد تصرف وفهم الآخر لما نقوله. وأن نقول الحقيقة يعني أن نلجأ إلى الحيوان، إلى الجماد، إلى الآخر، إلى كل ما هو غير إنساني. نلجأ إلى المجاز، إلى عمل اللغة. إذ لا يمكننا أن نقول الحقيقة وحدنا، اعتمادًا على أنفسنا. لا يمكننا قول الحقيقة سوى في جماعة. جماعة من الأحياء والموتى، من البشر والحيوان. جماعة تتحدث بلسان مقطوع. أما الصدق فهو مفرط في إنسانيته. لا يحتاج إلا إلى قوة العزيمة. الصادق لا يحتاج إلى أحد لكي يصدق. لا يحتاج إلا إلى نفسه، ولا يعتمد إلا على قوته، وصلابة إيمانه بنفسه. لكي نقول الحقيقة لا بد من أن ينطق الحجر، وليس ذلك مجرد “مجاز”.
الحجر الناطق ليس خيالًا، وليد طه الذي أصبح حمار وحش بحجم تيس ليس كذبة، بل كلاهما جزء من جماعة تقول الحقيقة، لأن قول الحقيقة يغرّب الواقع عن نفسه على أمل أن يخلصه من اغترابه. هذا هو الواقع الذي يقف الصادق أمامه ويظن أن باستطاعته أن يمسك بحقيقته من دون مجاز. فالحقيقة بالنسبة له نقية طاهرة، لا تشوبها شائبة، يظن أنه سيصل إليها مباشرة بضربة واحدة، دون المرور عبر عمل اللغة المضني. أما من يقول الحقيقة فيعرف أنها مشوهة حد الجمال، مليئة بالندوب، لأنها جماعية، ومجال تفاوض دائم. يعرف أن الحقيقة هي نقيض الصدق، وليست صنوه.
قول الحقيقة هو عمل الحِداد الذي يستلزمه كل ذلك الخراب الذي يتراكم يوما وراء يوم. لذلك من الأنزه دائمًا قول الحقيقة بدلًا من الصدق. فالصادق لا يقول إلا نفسه. الصادق يختال بقدرته على الصدق، وعدم الكذب. عندما يصدُق يقول لسان حاله مزهوًا: انظروا إليّ، انظروا إليّ، لقد استطعت ألا أكذب. كلكم تكذبون، أما أنا فلا أكذب. هؤلاء من يصدقون أنفسهم، ويصدقون ما يفعلون، ويصدقون ما يقولون، هؤلاء المتماهون مع الحقيقة، هؤلاء المثاليون، هؤلاء الأرواح الجميلة، هؤلاء الشهداء، هؤلاء الذين لا يتحدثون إلا مع أنفسهم، هؤلاء الذوات النقية، هؤلاء الطهرانيون، هؤلاء الناجون من الدنس، هؤلاء الذين لا آخر لهم، هؤلاء الذين لا يحتاجون آخر لكي يقولوا شيئًا، هؤلاء الذين يحلون تناقضات واقعهم بسكنى مدن فاضلة مغلقة عليهم، كل هؤلاء لا يقولون الحقيقة أبدًا. الكتابة التي تنكر قول الحقيقة هي كتابة صادقة، والكتابة الصادقة هي كتابة مثالية، مزهوة بنفسها، لا تريد سوى أن تثير إعجاب من يقرأها. وهناك الكثير من الكتابات الصادقة حولنا اليوم، وقليل من الكتابات التي تريد قول الحقيقة.
أنا مدين بالكثير لرحلتي مع وليد طه التي لم تنته بعد. مدين للقاء لا أعرف من خططه. مدين للغة سمحت بعودتي إلى الكلام مع الفانين، مع هؤلاء الذين ولدوا، ولم يموتوا بعد. لأن الكفّ عن الكلام معهم جعلني بلا أصدقاء أو حلفاء. الكفّ عن الكلام مع الفانين جعلني مجرد صادق آخر. لكن العودة للكلام مع الفانين لا تعني أني توقفت عن الكلام مع الموتى ومن لم يولدوا بعد، بل تعني أن اللغة الوحيدة الممكنة للكلام مع أقراني الفانين هي لغة يجب أن تمر عبر طبقات الخسارة والفقد اللانهائية، لتعود مشوهة حدّ الجمال.
شَكَلَ
الأَشْكَل في اللغة هو ما اختلط شكلُه بآخر. ماءٌ أشكَلٌ على سبيل المثال هو ماء اختلط بسائل آخر. ورجل أشكل هو رجل خالط بياضَ عينيه الاحمرارُ. ومن جذر شَكَلَ نفسه نمت المشكلة والشاكلة. هناك إذن صلة قرابة مثيرة للانتباه في العربية بين مفهومي المشكلة والشكل. كيف يمكن فهم هذه القرابة؟ إذا كان الشكل يعني الظهور، أو على نحو أدق، يعني وجود علاقة ناظمة للحظات الظهور المتعددة، أي الشاكلة، فإن المشكلة هي التباس شكل الظهور، وبالتالي فهي أزمة تطرأ على هذه العلاقة. لون العين مثلًا هو شكل استقر على بياض يحيط بسواد، ثم طرأ عليه اختلاط باحمرار، فأشكَل، ولم يعد على شاكلة نفسه. المشكلة تعني إذن أن العلاقة الناظمة للشكل قد تعطّلت، وأننا نجد أنفسنا أمام استثناء لا يندرج في هذا الظهور العام. الرجل الذي يخالط بياض عينيه الاحمرار هو حالة فردية تعطّلُ عمومية شكل بياض العين. يمكن القول إذن أن المشكلة هي لحظة اصطدام كليّة الشكل بصخرة الفردية، أو لحظة مقاومة الفردية لابتلاعها من قبل الكليّة، بعد أن أضحت الأخيرة مجرد شكلانية فارغة.
إذا كانت المشكلة هي صدع في العلاقة الناظمة للشكل، فمالذي يتعين علينا فعله عندما نقف أمام مشكلة؟ أمامنا فيما يبدو حلّ من اثنين. إما أن نعيد للشكل المهيمن نقاءه، ونخلص الشاكلة من شائبة الشوب التي شابتها، فنصبح نحن والفاشيون في ضفة واحدة من التاريخ. وإما أن ننحاز إلى الصدع ونسعى إلى تجذير مقاومته للكلية الفارغة. لكن كيف يمكن لهذا الانحياز أن يتجسد؟ يشيع اليوم استخدام فعل أَشكَل، وأحيانا مَشكَل، بقصد التوقف عند ما يبدو أنه عادي، ومحاولة تحويله إلى مشكلة. نقول مثلا أننا نريد أن نؤشكل (وأحيانا نمشكل) أمرًا ما، ونقصد أننا نريد مساءلته، لإظهار أبعاد أخرى متوارية وإشكالية لما نقف أمامه. ونظن أننا بذلك انحزنا إلى الفردية التي تَسبَبَ ظهورُها في المشكلة، لكننا لا ننتبه إلى أننا نستخدم فعل أشكل هنا على نحو غير دقيق. فمن يقف أمام مشكلة في الجملة العربية يكون موقعه هو اسم مجرور وليس فاعلًا. نقول: أشكل عليّ الأمرُ، أي التبس علي. من يُشكِل ليس نحن، بل الشيء. نحن وظيفتنا أن نتلقى تعقيدات والتباسات أمر ما، أما تصور أننا بإمكاننا إضافة تعقيد من الخارج فهو مبالغة في تقدير دورنا كبشر. فوفقًا لمنطق العربية، المشكلة في جذرها ليست تعقيدًا رأسيًا، يضيفه بشر إلى شيء خارجهم، وإنما هي تعقيد أفقي، أي التباس في الشكل ومن ثمّ تعقيدٌ للعلاقة الناظمة له.
لنعد إلى وصف المشكلة بأنها سؤال يتعلق بالشكل، وتحديدًا بوصفها الصدع الذي تحدثه مقاومة الفردية للاندراج في شكل مهيمن. أمام فاشية الكليّة الشمولية يجدر بنا أن ننحاز إلى الصدع الذي تمثله المشكلة، ونستقبل تعقيدات التباسها، مصرّين على اختلافها. لكن ما هي هذه التعقيدات والالتباسات؟ أليس كل التباس هو انزلاق ينبهنا إلى أن الشكل الكلي الحالي لم يعد كافيًا، وأن موضوع بحثنا بحاجة إلى إعادة التفكير فيه من خلال ربطه بما انزلق إليه؟ أي من خلال ربطه بعلاقات جديدة؟ أليست التعقيدات التي تحدد الحالة الفردية المسببة للمشكلة، والتي تصر على فرديتها واختلافها، هي في الواقع توسيع للعلاقات التي تربطها بما هو خارج شكلها المستقر؟ مشكلة الرجل الذي اختلط بياض عينيه بالاحمرار مثلًا تجعل من لون العين شكلا يتحدد بمحددات أخرى غائبة، ألا هي الشرايين المنسية، التي تغذي هذا البياض. مما يجعل لون العين شكلًا حيّا، وليس شكلا قياسيًا فارغًا. يجعل لون العين طرفًا في كلية أكبر هي صيرورة الجسد. أي أن الانحياز إلى الصدع الذي تمثله المشكلة يعيدنا إلى الشكل بوصفه علاقة داخلية بين لحظات مختلفة، وبالتالي يعيدنا إلى الكلية، أو بشكل أدق يدفعنا إلى مراجعة الكليّة التي أضحت مجرد كليّة شكلية فارغة، وإعادة التفكير فيها لنخلق شكلًا جديدًا، ونسعى إلى كليّة أخرى لا تقوم على الاستبعاد.
لكن متى أضحت الكليّة شكلانية فارغة؟ على الأرجح عندما توقفت عن أن تكون ظهورًا للمضمون. أي عندما جَرّدت المضمون من تعقيداته، وحولته إلى شكل مستقر ورتيب. والمشكلة بهذا المعنى ما هي سوى ظهور مضمون جديد يقاوم الشكل المستقر، ويُظهِر تناقضاته، سواءً كان هذا الشكل المستقر هو شكل أدبي، أو شكل اجتماعي، أو شكل سياسي. وبالتالي فالمشكلة هي لحظة تاريخية أفرزتها حركة الشكل. لكن الأهم هو ملاحظة أن فهم المشكلة بوصفها سؤالًا يتعلق أساسًا بالشكل واختلالاته أو التباساته، كما تقترح العربية، يعني عدم الاكتفاء بلحظة الفردية، بل المضي قدمًا إلى الشكل الجديد الذي فجرته هذه الفردية. المشكلة بما أنها التباس في الشكل، فهي تبحث عن شكل جديد يستوعب الصدع الذي حدث. بكلمات أخرى، المشكلة ليست بحاجة إلى حلّ، وإنما المشكلة بحاجة إلى إعادة تشكّل. مهمتها ليست ترميم الشكل القديم، وإنما إيجاد شكل لما كان منسيًا ومستبعدًا من الشكل القديم. وعندما نعمل على مشكلة، فإن ما نفعله هو استخراج شكل جديد، يلبّي حركة تناقضاتها. باختصار مفهوم المشكلة في العربية قد يتيح لنا الإصرار على الشكل، من دون الوقوع في شكلانية فارغة.
هناك مفاجأة أخيرة ينطوي عليها فعل شَكَلَ، جذر كل ما سبق. وهي أن شَكَلَ يعني ببساطة اشتبه والتبس. أي أن أساس معنى الفعل هو المشكلة، أو أن المشكلة سابقة على الشكل لغويًا. إذ لكي نصل إلى الشكل نحن بحاجة إلى تضعيف فاء الفعل مثلا، شكَّل، أو إضافة تاء بعد التضعيف، تشكّل. تَقدُّم المشكلة على الشكل لغويًا يفتح الطريق لإمكانية تقدمها عليه منطقيًا أيضًا. فزمن اللغة يقترب من زمن المنطق، ويختلف عن زمن التاريخ. بكلمات أخرى، قد يكون الشكل نفسه مُؤسّسًا على مشكلة، ويحمل معه إمكانية، بل وضرورة، الالتباس. الشكل إذن ليس مجرد انتظام العلاقة بين لحظات الظهور، بل هو ضرورة أزمتها. أي شكل حيّ هو شكل هش ومتصدع دوما، وسيقود لا محالة إلى مشكلة، لإنه إعادة تشكّل دائمة. ومن ثم لا يجدر تصور وجود شكل أولي أو أصلي تنبع المشاكل من اختلاطه والتباسه، وإنما العكس قد يكون هو الأدق. في البدء كانت المشكلة أو التناقض، سواءً أكان تناقضًا جماليًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا، ومن هناك ينبع الشكل.
لا
أين تقع الكتابة؟ يخبرنا السهروردي أن هناك بلادًا تلي أقاليم الدنيا السبعة وتسبق ملكوت الأرواح. بلاد تقع خلف جبل قاف، آخر حدود العالم المحسوس. هذه البلاد يسميها السهروردي ناكُجا آباد، وهو تعبير غير مألوف في اللغة الفارسية. البادئة “نا” هي أداة النفي “لا”، وكلمة “كُجا” تعني أين، أما “آباد” فهي الحاضرة الغنّاء. يعني تعبير السهروردي إذن “حاضرة اللا أين”. إنها بلاد متخيلة وواقعية في آن، تتوسّط المعقول والمحسوس، وتُداخل فيما بينهما. ليست هذه البلاد مكانًا يمكن السؤال عنه بأداة أين، وإنما هي أقرب إلى الفجوة أو الهوّة. هي حرفيا “لا مكان” يقع حولنا في كل مكان، ويمكن أن تنفتح هوّته في أي لحظة، فتهب رياحه على الحاضر. هواؤه قادم من الماضي السحيق، ويحمل معه رغبات المستبعدين وآمال المنسيين، وكلام من لا لسان لهم. بلاد اللا أين قد تكون أحد المواضع التي تتجاوز فيها غنوصية السهروردي نفسها. فهي تكشف عن حيز ينفي المكان الواقعي، ويواجهه بما استبعده ونسيه. أي أنها بلاد لا تكتفي بأن تكون حيزًا صوفيًا نقيًا وبعيدًا عن العالم الدنيوي، أو عالمًا بديلًا يمكن الهروب إليه، وإنما تريد أن تكون حيزًا أرضيًا، تعمل فيه أداة النفي “لا”، وتسري فيه قواها من أجل إحداث شقوق في ما هو قائم.
لم يسبق لأحد أن استخدم تعبير ناكُجا آباد قبل السهروردي، الذي كتب بالفارسية والعربية، ولم يشع استخدامه من بعده. لكن معظم قصصه الصوفية تنطلق من هذا اللا مكان، وتدور فيه، حتى ولو لم تسمه دائمًا. هو إذن مجاز غير مألوف في اللغة، اشتقه كاتب لكي يجد شكلًا لتناقض لا يمكن حلّه. تناقض يجسّد اختلاف الواقع مع نفسه، واستحالة انطباقه على نفسه. لذلك يمكن القول إن بلاد اللا أين هي بلاد أدبية المنشأ، ظهرت إلى الواقع من خلال الكتابة. بل يمكن المضي قدما والقول إن هذه البلاد هي موطن الأدب الأصلي، تنفتح فقط عندما يلامس الأدب الواقع، وهو لا محالة فاعل. بلاد اللا أين تحمل في طياتها مغامرة الكتابة في محاولة إيجاد شكل للتناقضات التي لا شكل له بعد، وليس حلّها. مغامرة عواقبها غير محددة سلفًا، قد تنجح مرة، وقد تفشل ويطويها النسيان مرات. وفجوة اللا مكان التي تنبثق منها هذه البلاد الأدبية، أو بالأحرى التي تحفرها حفرًا، هي نقطة التقاء الكتابة بالواقع، وفيها تكمن إمكانية مراجعته.
عمل
أين يذهب الكاتب بين عملين؟ أين تذهب العاملة بين ورديتين؟ العمل كما يفهمه ربّ العمل هو بذل لطاقة معينة من أجل تحقيق غاية محددة سلفًا. وظيفة هذه الطاقة تتمثل في أن تقوم بتذليل العقبات في طريق إنجاز الغاية المنشودة أو المنتج المُرام، والذي ما أن يظهر حتى تتم تسوية التبادل بدفع أجر العمل، ويختفي بعدها من قام به. تشغيل الماكينة في مصنع مثلًا هو عمل من أجل إنتاج علبة مناديل ورقية، والكتابة هي عمل من أجل الوصول إلى نص منشور.
رب العمل، الذي لم يعد شخصا، لا يرى العاملة سوى وهي تنجز منتجها، وتأخذ أجرها وفقًا لسعر السوق، وما عدا ذلك فهي تغفو خارج التاريخ. العاملة تبقى بالنسبة له مجرد حياة عارية ما دامت لا تعمل. فالعمل وفقًا لمعادلته الصفرية يساوي منتجه، وينتهي بمجرد دفع الأجر المكافئ، متعاميًا بذلك عن هذا الجزء من قوة العمل الذي لم يدفع أجره، الذي أسماه ماركس فائض القيمة. لكن الحقيقة هي أن العاملة تعمل أيضا وهي تسير عائدة إلى بيتها والريح تدفعها في ظهرها، وتعمل وهي تعدّ وجبة العشاء لأسرتها، وتعمل من أجل أن تستعيد القدرة على تشغيل الماكينة في مصنعها في اليوم التالي. والكاتب يعمل وهو لا يكتب لكي يصبح الكاتب الذي يستطيع كتابة عمله القادم. استعادة القدرة على القيام بعمل الغد، التي يُفترض أن يحققها أجر قوة عمل العاملة أو الكاتب، تبقى غير ممكنة، لأن هذا الأجر، بنيويًا، لا يمكن أن يكفي أبدًا.
العمل الأدبي يصرّ على رفض المعادلة الصفرية البرجوازية، ويصرّ على استحالة حلّ التناقض الجوهري الذي يسكن عملية الإنتاج نفسها. فالعمل الأدبي ليس منتجًا تؤُتي فيه كل ذرة طاقة بُذلت فيه أُكلها، بل هو في الحقيقة ما يفيض عن هذه الطاقة. فائض القيمة الأدبي هو قوة الماضي الذي لم يمض بعد. هذا هو الفائض الذي لم يُسكّن، وهذه هي الأثمان الباهظة التي تُعوض. والعمل الأدبي يكد ويكدح لكي يجد شكلًا لهذا الفائض الذي تم استبعاده ونسيانه. وبالتالي فإن ما يحدد حقل الإنتاج المسمى الأدب هو أن العمل المبذول فيه لا يهدف إلى إخراج منتج محدد إلى النور. العمل المبذول في الأدب هو إصرار على علاقة مع عمل الماضي، أي عمل ما استُبعد، ولا يمكن أن ينتهي بخروج منتج، لأن ذلك يعني وضع نهاية لعمل الماضي المفتوح، ومحاولة تناسيه من جديد. إذا فكرنا في العمل بوصفه تركيبًا للعناصر المختلفة التي تكوّن المنتج، مثلما يفعل رب العمل، أو بوصفه خطوات منطقية تصل بنا إلى المنتج النهائي، فلن نصل سوى لوثن بلا سحر. ولن يكف فائض القيمة عن إرباك معادلاتنا، ليعيد إلينا الماضي الذي لا يريد أن يمضي.
الكاتب يعمل دائمًا حتى وهو عاطل عن الكتابة. يراجع ويفند. يودع نفسه ويناقضها. فالكتابة ليست مجرد نشاط يمارس في أوقات معينة. بل الكتابة هي طريقة الكاتب في العمل على تاريخ عمله ومحدداته. هي طريقة الكاتب لكي يكون كائنًا تاريخيًا. وهذه الصفة لا تسقط عنه عندما لا يكتب. الكاتب يسير في صيرورته التاريخية، يموت ويولد من جديد، مثله مثل كل الكائنات التاريخية، سواء أنتج أعمالًا منتهية أم لا. وعمل الكتابة ليس هو الجهد المبذول لكي يصل الكاتب إلى كتابه فحسب، إنما هو أيضا ما يسمح للكاتب أن يرى ويتعلم من تناقضات عمله، وما يتيح له الخروج عن نفسه. لذلك فإن رهن عمل الكتابة بالعمل الأدبي المُنجز يعني حرمان الكاتب من القدرة على التناقض الذاتي، ومن ثم تجميده وإخراجه من التاريخ، حتى يعود بعمل جديد يكمل ما بدأه ولا يختلف معه. وكأن التاريخ يتوقف بين كل عملين. تمامًا مثل العاملة التي يحذفها البرجوازي من التاريخ، ولا تعود إليه سوى في اليوم التالي عندما تبدأ وردية جديدة. تعود إليه كما غادرته، لتبقى دائما عالقة، تبقى دائما ثابتة على حالها.
رهن عمل الكتابة بالمنتج الأدبي هو موت الكتابة. والطريقة المجردة في فهم الكتابة بوصفها عملًا موجهًا نحو منتج ليست فهمًا خاطئًا لطبيعة العمل فحسب، بل هي تنتج أيضا نصوصًا سيئة. إذا عُميت عيون الكتابة عن العلاقة المفتوحة مع الماضي، وعن إيجاد شكل لما استبعد، فإنها تسقط في وهم مفاده أن الماضي قد مضى، وأن صفحة الكتابة تبدأ دائما من الحاضر. النصوص التي تنتجها مثل هذه الكتابة هي نصوص تبدأ من فراغ أبيض معقم، ومهما حاوَلت فإنها لا تستطيع ملء هذا الفراغ، ولا إخفاءه. وسيظل هذا الفضاء المجرد يتلبسها كحكم مسبق بالإعدام.
طِباق
ورقة الكتابة حالكة السواد. مليئة بالحتميات والجرائم. الأمر الوحيد المعقول الذي يمكن فعله بشأنها هو محاولة تحرير مساحات من قلب هذا الظلام. فوق كل ورقة يربض عدد لا ينتهي من الأفكار الجاهزة، ومن مصاصي الدماء الذين يعيشون على عمل ضحاياهم. والكاتب الجدير بهذا الاسم لا يكتب، وإنما يحل وثاق الكتابة. لا يبدأ بحرية أن يكتب ما يشاء، وإنما بضرورة ملحة لتحرير مساحات من الظلام الحالك. ضرورة عمله الداخلية تشتبك مع الحتميات الجاهزة، فينشأ الصراع الأهم الذي يدفع الكتابة إلى الأمام. ومن دون هذا الصراع لن يتحرك العمل خطوة واحدة.
ورقة الكتابة ناصعة البياض. بياضها قاتل، لأنه أصبح عاديًا. هذا البياض أضحى شفافًا، ولم نعد حتى نراه. إنه بياض الحتميات التاريخية والأفكار الجاهزة، التي تقدم نفسها بوصفها الطبيعة التي تسير بها الأمور. بياض ورقة الكتابة هو بياض كولونيالي، جرائمه أصبحت منسية، والوضع الذي تمخض عنه أضحى عاديًا. وضع نظيف ناصع، لا أثر لأي عنف يسري فيه. أن يكون هناك مهاجرون فقراء يسعون للذهاب إلى مهجر ثري أضحى وضعًا عاديًا، لتغيب حقيقة أن هذا الفقر، وذاك الثراء، ليسا عاديين، وإنما نتيجة تاريخ طويل ومستمر من الاستغلال وسلب الموارد. بياض ورقة الكتابة قاتل لأنه يسوّغ ويمُنهِج العنف. إزاء هذا البياض ماذا باستطاعة الكتابة سوى تعكيره ومراجعته. سواد الكتابة هو محاولة لخدش هذا البياض المسيطر. محاولة لجعله على الأقل مرئيًا.
ليس
ورد في باب أيس في مقاييس اللغة لابن فارس القزويني ما يلي:
الهمزة والياء والسين ليس أصلٍا يقاس عليه، ولم يأتِ فيه إلا كلمتان ما أحسَِبهما من كلام العرب، وقد ذكرناهما لذكر الخليل إيّاهما. قال الخليل: أَيْسَ كلمةٌ قد أُمِيتَتْ، غير أن العرب تقول: “ائت به من حيثُ أَيْسَ وليس” لم يُستعمل أَيْسَ إلا في هذه فقط، وإنما معناها كمعنى [حيث] هو في حال الكينونة والوُجْد والجِدَة.
وقال: إنّ “ليس” معناها لا أيْسَ، أي لا وُجْدَ. والكلمة الأخرى قول الخليل إنّ التأييس الاستقلال؛ يقال ما أيّسْنَا فلاناً أي ما استقلَلْنا منه خيرًا. وكلمةٌ أخرى في قول المتلمِّس: قال أبو عبيدة: لا يتأيَّس لا يؤثِّر فيه شيء. وأنشد: أي لا يؤثّر فيه.
ليس، كما علمتنا دروس النحو، من أخوات كان. وهي فعل ماض ناقص يفيد النفي. تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لكن ها هي المعاجم تخبرنا أن كلمة ليس تنطوي على تعقيدات غير متوقعة. فعملها، أي النفي، يتكشّف عن نفي مركب، وذلك لأن الكلمة هي نفسها تحمل نفيًا ذاتيًا داخلها. فكما رأينا تتكون كلمة ليس، وفقا للخليل، من لا + أيْسَ، أو بكلمات معاصرة، من لا + وجود، أي أن الكلمة تعني باختصار “لاوجود”. وبذلك فإننا إذا نظرنا إليها بوصفها كلمة واحدة، أي ليس، فإنها تعود على كلمة مُثبتة، بينما إذا نظرنا إليها بوصفها كلمتين، أي لا + أيْسَ، فإننا سنرى ذلك الإثبات منفيًا داخل نفسه، أو متناقضًا مع نفسه. كلمة ليس هي إذن تناقض ذاتي، فهي إثباتٌ منفي.
وبما أن ما هو منفي داخل كلمة “ليس” هو الوجود، فإن ذلك يعني أنها تحمل معها وجودًا مكسورًا داخل نفسه. ما كسره هو علاقة نفي داخلية، فالأداة “لا” قد ذابت في نسيج ما تنفيه، أي الأيس أو الوجود، فحركته عن مكانه، ونشأت عن ذلك كلمة “ليس”. وبالتالي فهي لا تنفي خبرها عن اسمه من خارجه، وإنما تلاقي جملة الاسم والخبر حاملة معها نفيًا داخليًا آخر، أو بالأحرى تأتي حاملة تناقضًا أساسيًا، وهو تناقض الوجود مع نفسه، وهو الوجود نفسه الذي تتقاسمه موجودات أي جملة كانت. وعندما تلتقي “ليس” بجملتها تنقل إليها أصداء التناقض الذاتي للوجود مع نفسه. فهي لا تنفي “وجود” خبرها، بل تفتح إمكانية وجوده متناقضا مع نفسه، لأن الوجود ذاته وفقا لكلمة “ليس” متناقض داخليًا.
بكلمات أخرى، قد يكون هناك في كلمة “ليس” ما يفتح الطريق أمام فهم مختلف للنفي الذي تقوم به، بخلاف المعنى المباشر والقريب لنفيها وهو نفي الخبر عن الاسم. قد يكون ما تفعله “ليس” هو أنها تتسرب إلى جملتها، تمامًا مثلما تسربت لا إلى أيس، لتذكرها بأن النفي ليس مضمونًا معرفيًا، أو حكمًا نهائيًا، أو مجرد حالة نقيضة، وإنما هو حركة تناقض ذاتي. ومن ثم فإن النفي لا يأتي من الخارج، وإنما ينبع من الداخل. كلمة “ليس” تلتقط بفضل تناقضها الذاتي التناقضات الداخلية لاسمها، فتحدث فيه شقًا، وتحركه عن مكانه، لكي يظهر شكل وجوده المتناقض.
كلمة “ليس” هي وحدة ما لا يتحد، أي وحدة الوجود مع نفيه. وهي حضور لما هو غائب، أي وجود “اللا وجود”. لذا فعندما ننفي خبر ليس فإننا ننفي معه كل مرة تجانس الوجود (لا + أيس/لا + وجود)، وبذلك نؤكد التناقض الضروري المتمثل في حضور ما لا يوجد، حضور ما استُبعد، ونؤكد التناقض الذاتي بوصفه الشكل الوحيد لوجود الاسم مع الخبر. قد تكون كلمة “ليس” إحدى هبات اللغة لنا، لكي تمنحنا شكلٍا لاستحالة تطابق الشيء مع نفسه.
كلمة “ليس” هي كلمة جدلية بامتياز، فهي تحمل معها ما تنفيه، ولا تلفظه جانبا. “ليس” تحمل معها “أيس”، التي اعتبرها الخليل “كلمة قد أُميتت. “ليس” تحمل معها موتاها، أخبارها. وكل خبر جديد تنفيه “ليس” يختلط بها، ويترسب داخلها، لتصبح كلمة مثقلة بكل تلك الشقوق التي أحدثتها. وبالرغم من ذلك تبقى رشيقة وشفافة كحدّ الشفرة.
ورطة
أنا لا أعمل في مجال الأدب. لستُ موظفا في جهاز ثقافي يدعى الأدب. علاقتي بالأدب لا يمكن وصفها سوى بأنها ورطة. أنا وقعت في ورطة اسمها الأدب. لذلك فكل كتاباتي ما هي سوى محاولات للخروج من هذه الورطة. ولدي خطة، لكنها ليست دائمًا ناجحة. خطتي هي أن أتورط أكثر في الكتابة، حتى تأخذ شكل تورطي في العالم. هذه هي الطريقة الوحيدة فيما يبدو لي التي يمكن التعويل عليها للخروج، لأن أي خروج لا يتضمن المرور عبر ما نرغب في الخروج منه هو هروب وليس خروج. الخروج الحقيقي هو خروج عبر التورط حتى النخاع.
أي عمل “منتهٍ” هو رسالة وداع لكاتب لم يعد موجودًا. إذ أن الكاتب بعد انتهاء الكتابة يكون قد مرّ عبر عمله على الكتاب، منتقلًا إلى مكان آخر. من الزاوية المقابلة، لم يعد الكتاب بحاجة إلى ذلك العائل الوسيط الذي يدعى الكاتب، بل ويكتشف رويدًا رويدًا أنه لم يعد هناك أي صلة مشتركة تربطه بالكاتب. لم يعد هناك كاتب، ولم يعد هناك كتاب. هناك فقط لحظة وداع، مفترق طرق، وواقع انتقل إلى نقطة كثافة مختلفة بفضل عمل الكاتب والكتاب المشترك. لذلك من الغريب أن يدافع الكتاب عن كتبهم. فالكتب لأصحابها هي شواهد قبور عزيزة، لأناس رحلوا عنا، لكنهم لا يزالون يعيشون في قلوبنا. هذه الكتب تستطيع أن تدافع عن نفسها بنفسها، لأنها لم تعد ملكنا. الكتب التي نكتبها ليست هي عملنا الذي يتراكم رأسمالًا شخصيًا، بل هي عملنا الدؤوب والمضني لكي نتحرر من أنفسنا، بينما نظن أننا في طريقنا لنقترب من أنفسنا.
الكتابة هي خبرة حقيقية، ومثلها مثل أي خبرة حقيقية هي خبرة لا نمتلكها، لأننا نحن الذين مررنا بها لم نعد موجودين، فالخبرة قد غيرتنا للأبد. المعايشات فقط هي ما يمكننا أن نراكمها بمعزل عن أنفسنا، كأنها معرفة خارجية نضيفها إلى أنفسنا. أما الخبرة فلا تراكم فيها. الخبرة هي الانقطاع الذي يحدث للذات المختبرة. هي الموت والولادة. الخبرة اختبار، والاختبار حدّ، والحدود لا تفصل فحسب، بل تُخترق أيضا. الخبرة الراديكالية ليست ما يُضاف إلى الذات، بل هي ما قد يؤسس لذاتية جديدة. ما قد يؤسس لحقبة جديدة وتاريخ جديد.
——————-
أمل السعيدي: شيء أكبر يكتب بدلا مني
مسقط، مسقت، مسكد. يختلفُ الصوت الذي عُرف عن العاصمة، اليوم عندما يتندر البعض أو يظهرُ خفة الظل، يقول أنا ذاهب إلى مسكد، ثم يضحكُ كثيرًا، ويبتسم الآخرون لهذه الذكرى…
شيء أكبر يكتب بدلا مني/ أمل السعيدي
المحاولة الأولى: اللمس (المدينة والكتابة)
النسخة الأولى التي قرأتها من الليالي كلها لـسعدي يوسف، الذي تعرفت عليه من خلالها، كانت مستعملة. عند بوابة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بداية عام 2011، وأمام زاوية طباعة المذكرات الدراسية كانت طاولات العارضين تصطفُ بتوازٍ، قلبتُ الديوان، لاحظتُ توقيعة في الصفحة الأولى، يتضمنُ اسم مريم.
سررتُ بأن الكتب تمرُ بأجسامها، وأن النسخة حتى وإن لم تكن مقروءة فقد عبرت في مناخات مادية أخرى. يقوضُ هذا شيئًا من شهوة أريد كبحها باستمرار في الإحاطة بكل العالم في نظرة واحدة، حتى وإن كانت ضعيفة لكنها حنونة. وعندما أحول نظري الذي أعاقبه إن نظر على نحو أقل، أسأل نفسي: ما الذي يحدثُ هنا الآن؟
تحيط بنا الجبال من اتجاهات متعددة، وعلينا أن نبرز نوعًا من التعميم عن حياتنا هنا الآن، لكنني أريد الإمساك بالجسم. ولا أستطيع فعل ذلك أبدًا. هل هي حياة مستوية إذن، حادة الأطراف، ليس لها ذيل ولا هامش؟ وأشعرُ بوهن، كلما عرفتُ أن الكتابة هنا هي طرفٌ من ترسانة التعميم القاتلة تلك التي تردي أشياء متطايرة، لا جثثًا يمكن الإمساك بها في حرب غير عادلة.
الجبال إذن، هل نقول شيئًا عن الكهوف المظلمة كلما قلنا هنالك جبل وبحر، خطوط الطول والعرض، تظهرُ كمحاولات باردة في السرديات التي أحتاجُ بشدة للتقاطع معها. مرةَ أخرى لماذا لا نمررُ أجسامًا، تساعدنا على العودة لإلقاء نظرة أولى غير متعجلة.
الجبال مجددًا، مكتوبة كما لو أنها ظل، خلفية موسيقية بلغة أجنبية، تطغى على أصوات الجالسين على الطاولات، يتوددون بعضهم أو يعلنون الكراهية، أو يضمرون انتقامًا ما، يفكرون في قرض الإسكان، في ضريبة القيمة المضافة، في سعر الكحول الذي زاد بنسبة 100% ثم عاد بنسبة زيادة 50%، أو يفكرون في أموالهم التي يحولونها للخارج، في مصارف سويسرا أو في جدوى الهرب من البيت، بينما البيتُ هنا أيضًا في مدينة لم تخلع عنها بعد لون القرية.
أصابع مترددة، تخشى العالم في العادة، ومع ذلك تمسكُ بجسم الجبل بصخرة منه، وتفتته أو تضع الصخرة على الكوميدينو بجانب الوسادة، تحرسها وتنامان معًا. على أمل أن تعبر تلك الصخرة.
الجبال إذن، على هذا المكان أن يضبط جسدي، لكنه بالنسبة لي ليس مكانًا واضح المعالم، لا أستطيع المقاومة لأنه ما من شيء لأقاومه. وبهذا فإنني أعيش في حلقة مفرغة، ليست حلقة نار للأسف، بل حلقة حدودها الهواء، ومع ذلك فإنها حلقة صلبة. أكاد أجنُ، على المدينة أن تكون ملهية، ممتدة، عليها أن تشبه المتاهة، الأفعى، لكنها تابوت، مسقط المتجردة، دون أي دعوة للمينيماليزم، الفارغة، ربما ليس عليها أن تمتلك أكثر من ذلك، لتحكمني، ولتجعل أفواهنا تُقبلُ الهواء. ماذا سأكتبُ إذن؟ أية قصة لديّ؟ لا قصة لديّ، ولا عنوان.
الجبال إذن، أريدُ أن تُمرر الجبال إليّ في فناجين القهوة، في الكتابة التي يكتبها الأحياء هنا، لكن الأمر لا ينتهي هكذا، ففي معادلة الجسم هذه، جسدي يعبرُ، يعبرُ، يعبرُ، يعبرُ. نقول في لغتنا المحكية “يعبر” أي ينتهي. ولا أكتب.
رمل مكتنز بكل هذه الخطوات والجري المسعور، بينما حمامة تقرضُ أطراف نبتة ذاوية أو شيء ما عليها. إيقاعُ الموج المنتظم يرقق الصخب، ثمة حاجز من أحجار ضخمة يسور هذا المكان المفتوح، أجلس في مقهى زيل في كمبنسكي /الموج في مسقط، أعقدُ مع طيف الغروب صفقتي الخاسرة مع المدينة. هل يمكن أن ألحق بهم وهم يركضون، النساء يرتدين ثياب السباحة، تلوحُ الشمس أجسادهن الممطوطة اللامعة، وأنا لا أتذكر بأنني كشفت ساقي لأحد بعد. ولا أعرف تمامًا إذا ما كان ملحُ هذا البحر هو نفسه ملح الطعام قبل أن يُنقى.
لدي فستان صيفي، موضة هذا الصيف ملونة وربيعية، قماش بارد، مطبوع ببتلات لوتس تبدو كما لو أنها تطير، مع فتحة صدر واسعة، تخيلته لحظة وقوع عيني عليه في المتجر يهفهف كثيرًا. ها هو ذا يفعلُ داخل الكتابة.
ظلال الجبال تعطي مشهدية هذا المكان المحجوز لقلة من الناس، شعورًا بأن الحراسة يمكن أن تستيقظ، كما لو أنها مؤخرة دب ضخم ما زال نائمًا. لا ينبغي أن نأمن شيئًا كهذا. فخلف تلك التلميحات الجبلية الراسخة، حربٌ خامدة وقطيع فراش ملون، رفرفة الكثير منها، سيوقد الطوفان.
رجلان يرتديان بدلتي رياضة من أديداس يتمرنان على الشاطئ ثم يتوقفان للحديث، شجرة بيذام (لوز) بجانب سلم المقهى الذي يؤدي لهذا الشاطئ الخاص تذكرني بمنزل جدتي وموسم قطاف البيذام والخوف من الدود، مكانٌ جيد للمواعيد الغرامية، لن يوقف أحدٌ هنا أي قبلة لرجل وامرأة أتيا من قرية بعيدة، لن توقفَ القبلة هذا التطير في استغلال اليوم لحظة بلحظة في اللهو واللعب.
بلهجة قروية يقول لي النادل “تريدي شيء بعد” وأقول: شكرًا.
محاولة ثانية: البحث عن النبرة ( الصوت والإيقاع)
مسقط، مسقت، مسكد. يختلفُ الصوت الذي عُرف عن العاصمة، اليوم عندما يتندر البعض أو يظهرُ خفة الظل، يقول أنا ذاهب إلى مسكد، ثم يضحكُ كثيرًا، ويبتسم الآخرون لهذه الذكرى. في مسلسلات الخليج التاريخية التي تُظهر شخصيات قادمة من عُمان، تقول إنها جاءت من مسكد، وبينما نتحلق حول تلفاز واحد في بيتنا، يحفزنا لفظ العاصمة على هذا النحو، فنمطُ رؤوسنا حتى وإن لم نتكلم، اذ ننتقل لمستوى آخر من الصمت. عرفت لفظة مسقط أو مسقت بهذين الشكلين منذ أوائل القرن العشرين، وكتب المؤرخ العماني السالمي في تحفة الأعيان مسقط في تأريخه لسنة 1894، لكنه وفي تأريخه لـ1903 كتبها مسكد، بالكاف والدال، ويمكن القول إن سبب إبدال الكاف بالقاف في رواية السالمي، مرتبط بلفظ السالمي وتدوين اللفظة، إذ كان السالمي ضريرًا. [1]
عندما أكتب، أقرأ ما أكتبه بصوت عالٍ لأتبين مواقع النشاز، في بعض الأحيان أحبُ أن أكتب أنني زرعتُ سروة في البيت، لوقع كلمة سرو، لكنني أنتبه أن صوت الكلمة وحده ليس كافيًا للمضي قدمًا في هذه الخطة، إذ أن السرو لا ينمو في عُمان. بل إنني وللمفارقة عندما سافرت لم أميز السرو عن البلوط.
تضحك نوف كثيرًا عندما تقرأ بعض مسودات نصوصي قبل نشرها، إذ تميزُ الأماكن التي أفتعل فيها لفظة لصوتها، وتقول لي إن الحقيقة لا ترتبط بالصوت وحده، لكنني أصرُ بدوري على أن الإيقاع هو جزء من الحقيقة ولا يمكن أن يكون هنالك شيء حقيقي بالكامل. يغطي النخيل ما نسبته 42% من إجمالي الأراضي المزروعة في السلطنة [2]. سألتُ أبي ما قصة الخلاف على النخيل في القرى القديمة في الجبل، قال “قسمة المال” تتم بعد أن يجتمع أعيان القرية (البلاد)، ولا تعطى النساء من النخيل، ويأخذ الأخ الأكبر النصيب الأكبر لأعذار منها السبلة. وبسبب اختلاط الأملاك، وعند توسعة الُملك (الجيل/الرابة/الجلبة/الضاحية) تحدث المشاكل، وقد تصلُ أحيانًا للقتل، لكنه ليس شيئًا صادمًا، إن الناس تقتل بعضها لأسباب أتفه من ذلك.
كانت أصناف النخيل المنتشرة في مزرعة والد أبي: النغال، قسويح، خشكار، قش، تبق، التي تعد من الأصناف المتوفرة أكثر من غيرها. ويختلف المحصول في قرى الجبال عن قرانا الحديثة، من حيث كمية الحصاد وجودته وطعمه، ويقول أبي إن تمور الجبال أكثر حلاوةً، ويقول إن لهذا أسبابه، إذ أن التمر يحتاج لأماكن جافة، ويتحقق ذلك في الجبل.
أعيد قراءة الفقرة السابقة، وأتوقف عند تنويعات كلمة الضاحية. أتوقف كثيرًا، وأقررُ المواصلة في الكتابة، علني أصلُ لجبل أبي الذي هو أكثر حلاوة لا في نخيله فحسب. وأتذكرُ بينما تواصل عملية الكتابة سحرها، إذ تكشف لي ما لا أعرفه عن نفسي وعن العالم. تذكرت بيتًا أحبه لمحمد الثبيتي وإن كنتُ قد استخدمته في سياقات الرد على الكارهين أحيانًا، يقول الثبيتي:
يا أيها النخلُ، يغتابك الشجر الهزيل
ويذمك الوتد الذليل
وتظلُ تسمو في فضاء الله، ذا ثمر خرافي
وذا صبر جميل
وأعرفُ أنني أمضي بكتابتي إلى مكان آمن، وأن النخلة صوتُ لفظتها، سيوصلني إلى هنالك سالمةً من تقريعات الإيقاع، والنفور.
محاولة قبل أن أستسلم
لقد حاولتُ، وأنتم شاهدون عليّ، أن لا أجرد أفكاري، أن أنطلق من المكان الذي أعرفه/أجهله، نحو ما أنا عليه الآن، لكنني لستُ واثقة من قيمة ما فعلت. أشعرُ كما لو أن نسمة تنحسر عن صدغي، وبألم في الحلق؛ أبتلع فشلي، ضمور الكتابة، الذي يوجعني جدًا، لكنني لا أستطيع أن أجرب شيئًا، وهنالك هذا كله الذي يطوقني، ويشلُ من حركتي، والكتابة حركة أليس كذلك؟
يقول لي صديقي إنني أشبه البطريق، ويستخدم ملصقات بطريق في وضعيات استلقاء متعددة. أنا مستلقية، كيف لي أن أكتب إذن؟ أو أن أقول شيئًا عن الكتابة. قال آخرون لا يحببونني كثيرًا: كتابتها ذاتية. ولا أعرف إن كانت هذه تُهمة حقيقية، وعلى من ألقي اللوم، إذا أردت التنصل منها، فأنا لا أشعر بنفسي سوى معطى نهائي، لأرضي، لمدينتي، لبيتي، لعائلتي، إنني لا شيء مني أبدًا. ولهذا أقتبس جورج بيريك من فصائل الفضاءات في كل مناسبة، إذ أيضًا يربط الكتابة بالمدينة، بالمكان، بأسفل السرير، لا يهم، إنها الفضاءات التي ينطلق منها السرد، وربما في نهاية الأمر لا يريد سوى العودة إليها وملامستها، وترك علامات من الدعة عليها لترفق بنا قليلًا بعد كل ما حدث.
لاحظتُ في الأوان الأخير أنني أميل لقراءة الأعمال التي تتحدث عن الشتاء أو تدور في فصل الشتاء، عندما يغطي الثلج كل معالم البلدة، ويُدوّرُ شحوبها الجديد أحداثها القديمة. أتوق للبرد، وأريد بدوري أن أكتب عن صحراء صافية، بيضاء ممتدة على طول النظر، وعندما تصلُ لآخرها لا تسقط! لكنني لستُ في صحراء بيضاء، أنا هنا، محاطة بمكونات صخرية خاصة ببلدتي، وأتمنى ألا أكون رمحًا في الكتابة عندما تكون تعميمًا، فهامشي على كتفي للأبد.
الاستسلام
“من يعلم، ربما كانت بعض حالات الانتحار المحيرة نتيجة لإحدى المحاولات، التي بدأت بتفاؤل شديد، وكانت تبحث عن الخط المثالي لنجاح اليوم. ولكن ألا يفصح لي عدم نجاح اليوم عن شيء آخر؟ ربما كان بداخلي تصور خاطئ مثلا؟ إنني لم أخلق من أجل اليوم بالكامل، إنني ليس علي أن أبحث عن الصباح في المساء. أم هل عليّ أن أفعل”؟
بيتر هاندكه، عن يوم ناجح- ص 40.
[1] محمود محمد هملان، مدينة مسقط ( 1900-1913) – مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية 2017.
[2] أحمد المرشودي، صناعة التمور في سلطنة عمان: الإنتاج والتسويق والمعالجة التعاون الصناعي في الخليج العربي– منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ص 13-26.
—————————
منى كريم: على أطلال الأدب القومي أو عن أدب يكتبه الغرباء
يتم الإشارة إليّ باعتباري كاتبة “عربية-أمريكية” بلا تردد، ولا أعلم متى بالضبط حدث التحول في تصنيفي من “كاتب عربي منفي” إلى كاتب “عربي- أمريكي”….
على أطلال الأدب القومي أو عن أدب يكتبه الغرباء/ منى كريم
ها نحن ثانية في المنفى، لسنا بأول جيل عربي يسّيب نفسه للمتاهة كما لن نكون الأخيرين، يسموننا مهاجرين تارة أو لاجئين ومهمشين تارة أخرى، يدعوننا للحديث عن الهامش من الهامش “كيف هو الطقس على الهامش؟” يضعوننا في أنطولوجيات لن يقرأها سوى مومياوات المؤسسات أو جيتوهات دراسات الشرق الأوسط، يتعاملون مع قصائدنا ورواياتنا باعتبارها وثائق، أو اعترافات من الجانب المظلم من النفق. أو قد يتطور الأمر قليلًا فيضعون شرطة هي بمثابة جسر ضبابي بين هويتنا وهويتهم “عربي-أمريكي”، جسر لا يهدف للعبور، يتولون حراسته، وسوف يبنون عليه حائطًا مكهربًا يومًا ما.
قضيت في الولايات المتحدة حتى الآن 10 سنوات. لم أحصل على الجنسية بعد وما زلت أسافر بجواز سفر لاجئ مدته 12 شهرًا، ويقتضي تجديده 3 شهور في كل مرة، باعتبار أن السفر رفاهية. يتم الإشارة إليّ باعتباري كاتبة “عربية-أمريكية” بلا تردد، ولا أعلم متى بالضبط حدث التحول في تصنيفي من “كاتب عربي منفي” إلى كاتب “عربي- أمريكي”.
في المقابل، ولدت وتربيت في الكويت حتى سن الثانية والعشرين، نشرت خلالها مجموعتين شعريتين، عملت في الصحف المحلية لخمس سنوات، بل أني لم أترك مجالًا إلا وتمرغت فيه: التمثيل، النقد المسرحي، الترجمة الأدبية، التنظيم السياسي، النسوي والعمالي و”البدوني”، لعبت على الكمنجة والعود والبيانو، ولولا أن صوتي شحيح وقبيح لوجدتموني أغني في المولات التجارية وعلى شواطئ الخليج الملوثة. عشت حياة ضخمة خلال عمر قصير، نجحت وفشلت وكبرت، كل ذلك دون مسمى أو مصنف أحمله.
في 2011، وبعد ولادة حراك “البدون” في الشارع الكويتي، صار هنالك شيء اسمه “أدب البدون”. من قبل، كانت أنطولوجيات وموسوعات الأدب الكويتي تتجاهل وجودنا، والتي لا هدف منها سوى تثبيت فكرة أن لدينا بالفعل أدبًا وبالتالي لدينا أيضًا أمة وتاريخًا ودولة، يقصوننا من “رابطة الأدباء الكويتيين” ومن كل جمعيات النفع العام التي من المفترض أن تكون أكثر ديمقراطية من الدولة إلا أنها في الحقيقة أكثر بؤسًا ورجعية وعنصرية.
نتصاحب ونتسامر مع رفاقنا المهاجرين، من المصريين والسوريين والفلسطينيين وغيرهم من العرب التائهين في بلاد النفط، نعرف أننا على الهامش، هامش الهنا وهامش الهناك، ولا نعرف كيف نخلق من هامشنا هذا شيئًا، جغرافية أخرى خاصة بنا، مساحة غير قائمة على السيد المواطن. لم يكن لـ “أدب البدون” أن يولد لولا أن حراك البدون قد ولد، فكل قضية سياسية بالطبيعة تحتاج إلى الأدب والثقافة لتسريد معاناة وحراك قوم ما نحو تطلعاتهم الجمعية. كانت النبذة التعريفية للواحد تأتي في سطر مبهم “ولد في الكويت” أو أن تكتب “شاعر بدون” فيقوم المحرر بإلغائها، إذ كيف يمكن تعريف الواحد بصيغة النفي.
في المنفى، تعرفت على شعوب خليجية أخرى، على كتاب أصولهم من الهند وإيران ومصر وفلسطين، ممن يكتبون بالإنجليزية، لكنهم ولدوا وتربوا في الخليج ثم انتهى بهم الأمر في المنفى لأسباب شتى. يقومون بالتعريف عن أنفسهم “كاتب من أبو ظبي” أو “شاعر من دبي”، بل أن بعضهم لا يجيد العربية حتى. استوعبت من خلال قراءة نصوصهم التي تصور خليجًا آخر تمامًا أن مخيلتي قد وقعت ضحية لتعريفات الأدب القومي، كيف نجحت مؤسسات الدولة في العالم العربي بأكمله بتثبيت فكرة الأدب القومي باعتباره أدبًا يكتبه المواطن وبالضرورة بالعربية، أدب مرتبط بهوية وسرديات الدولة، لا بالجغرافيا التي هي الوعاء الطبيعي لكل فعل إبداعي. نُزلت منظومة الدولة في العالم العربي أو حتى في العالم الثالث بذات الشكل الإسمنتي: كي تختلق دولتك، اصنع ثقافة فلكورية وأدبًا وفنونًا وأزياء محلية، هكذا ستصبح الكذبة حقيقة لا محال.
أرسل عبد الناصر لجانه المختصة إلى كافة أنحاء الخليج ينظمون عمليات ومسارات الثقافة ليمرروها من بعد لأجيال المواطنين يحرسونها ويتفاخرون بها بصدور مفتوحة. وضمن هذه العمليات العنيفة، لم يترك أحدهم أي مجال للمهاجر أو البدون أو أي عابر آخر عالق معهم ليشارك بمنتجه الثقافي هو أيضًا. ترعرعت في بلد، بعد حرب الخليج، كان تلفزيونها الوطني يقوم بقص أسماء الفنان الفلسطيني أو العراقي من تترات المسلسلات والبرامج، بل حد الوصول لإلغاء مشاهد كاملة من “ثقافتهم الوطنية” لأنها من صنع أو تمثيل العدو الجديد، وكان الناس يتداولون كاسيتات كاظم الساهر وياس خضر من تحت الطاولة كما ممنوعات الخمرة والحشيش. بعد احتلال العراق 2003، احتفل الناس بالأعياد الوطنية في الكويت بشكل مختلف وقتها، تتزاحم سياراتهم على شاطئ الخليج صادحة بالأغاني العراقية بأعلى صوت. الله، الحرية، أن تسمع موالًا عراقيًا في الشارع.
في مقالة عن خماسية مدن الملح لـ عبد الرحمن منيف، كتب الروائي الهندي أميتاف جوش مقالة استثنائية بعنوان خيال النفط تنسف مشروع الأدب في الخليج. يناقش جوش كيف أن الأدب في كل مكان لم يعرف كيف يتعامل مع اكتشاف النفط، فاستنباط هذا الخام الذي غير موازين القوى في العالم، يحدث في أماكن بعيدة عن ناظر الإنسان، ثم تتم مداولته في أسواق متخيلة لا نعرف عنها سوى مؤشرات الأسعار خلال النشرة الاقتصادية. ثم يركز غوش على أن مدن الملح قد تكون المحاولة الأدبية الوحيدة لفهم هذا اللقاء المهيب بين الإنسان والنفط، وفي منطقة وعرة جدًا هي منطقة الخليج حيث التاريخ لم يمر بمراحل تطور طبيعية من الإقطاعية إلى الثورة الصناعية فالرأسمالية النفطية.
على العكس، وكما نفهم من رواية منيف، تحولت الخليج من جغرافيا جماعات صغيرة متوزعة بين ضفتي الصحراء والبحر إلى دول ومدن تنمو أسرع مما يسع لرئتي التاريخ احتوائه. حين تفتح رواية ما عن الخليج تلاحظ كيف أن هوّة النفط أو هوّة الحداثة هائلة ومظلمة ومليئة بالصمت، كل عمل يقفز من توصيف الحياة البسيطة إلى إشكاليات وطموح الحياة الحديثة. ولكن ماذا عن ذاك الشرخ، عن الايكولوجيا التي ضاعت في المنتصف، أن تكون الصحراء صالون بيتك في الأمس فتصبح حبيس بيت اسمنتي في اليوم التالي؟ لا شيء.
يناقش جوش التدخل الذكي الذي أقدم عليه منيف في الجزء الأول من الخماسية، في التقاط هذا التناقض المريب الذي بطبيعته سهل من جعل المنطقة ساحة يلعب فيها الأمريكان بحرية، لكنه يعبر عن فشل منيف في الجزء الثاني من الرواية حينما يستسلم لثنائية المواطن و”الوافد” ليعتبر هذا الآخر المستلب جزء من المنظومة التي تسرق الأرض والحرية بمشروع النفط. وقد يكون فشل منيف هذا استعارة كبرى لفشل الأدب في الخليج حتى اليوم في خلخلة السردية التاريخية المهيمنة وفي هدم ثنائية المواطن والآخر، بل وحتى في التحرر من أكذوبة الأدب القومي التي لم تكن لا قبل النفط ولا بعده لائقة بالمنتجات الثقافية على أرض الواقع.
لا أطمح اليوم لشَرطة (-) أضعها بين هويتين، لا أظن أن هذه العلامة الترقيمية ستخلق مكانًا لروايات إبراهيم عبد المجيد وصنع الله إبراهيم وغسان كنفاني ومحمد الأسعد وخزامة حبايب ويحيى يخلف ووليد أبو بكر وأحمد زين والصف الطويل العريض من الكتاب العرب والجنوب آسيويين والأفارقة الذين عاشوا أو كتبوا عن الخليج. ولكني أعرف أن بإمكاني حتى ولو بملعقة واحدة في يدي أن أنسف هذه الجدران التي يحتمي بها الأدب القومي، ومن يكتسب مساحة لنفسه من خلف هذه الجدران.
———————
يوسف رخا: أكتب كعاشق أَكتب كميّت
أعتقد أن الكتابة تبدأ من نقطة عميقة بين فم المعدة والقفص الصدري. لا أقصد أن أتفذلك أو أكون شاعريًا. أعتقد أن هذا هو موقع الحركة المعنيّة من جسم الإنسان بالفعل…
أكتب كعاشق أَكتب كميّت/ يوسف رخا
وما استغربت عيني فراقا رأيته، ولا علمتني غير ما القلب عالمه.
أعتقد أن الكتابة تبدأ من نقطة عميقة بين فم المعدة والقفص الصدري. لا أقصد أن أتفذلك أو أكون شاعريًا. أعتقد أن هذا هو موقع الحركة المعنيّة من جسم الإنسان بالفعل. وجع لا يُحتمل يدفعك إلى أن تنطق وكأن حياتك متوقفة على ما تقوله. وكأنك نسيتَ أن الكلام تدليس وفراغ لا يداوي. وسط متاهات اللغة كما تُعاش، على شبكات التواصل الاجتماعي بصاق وسكاكين ومشانق معلّقة بلا محاكمات، هل عاد في الكلام أصلًا مساحة لأي معنى؟
ومع ذلك، مع أن المكان سجن والزمن خدعة والناس أساطير، ما إن تحصل تلك الحركة في جسمك حتى يصبح اختيار وترتيب كلمات معيّنة على نَسَق معين مسألة حياة أو موت. وحدها الحركة المعنيّة تُطلِق الكتابة مثل ضربة أسفل الركبة مهما قاومتَها تؤدي إلى ارتفاع الساق. ليس هكذا بالضبط، لكن مساحة الإرادة أو الاختيار ضيقة فعلًا. وبالاستسلام للحركة يخِفّ الوجع قليلًا لكن لا يحصُل شفاء.
في النوبة التالية يمكن للأمر أن يتكرر، ولو تكرر عددًا كافيًا من المرات يمكن أن يصبح طريقة لمواجهة الحياة بالفعل. عندما تصبح الكتابة طريقة لمواجهة الحياة لا يمكن أن يكون الهدف من ورائها استعراض معرفة أو ذكاء، ولا يمكن أن يكون تفاصُحًا أو تنميق أسلوب. أقصد أنه حتى عندما يكون كذلك فتلك الأشياء هي الغلاف المطاطي المحيط بسلك يحمل التيار من جذعك إلى دماغ آخر. كهرباء تولّدها استحالة الحب وحتمية الموت وأشياء أقسى من الذكريات. كل أولئك الذين يخذلونك إلى حد الانتحار، بلا كتابة ماذا تصنع بأشباحهم؟ الحقيقة أنه يستحيل وجود هدف أصلًا.
طبعًا مع الوقت والدُربة، عندما تعمل في الصحافة أو تحترف نوعًا أدبيًا، تصبح هناك أهداف محدّدة، أن تسوق حجّة أو تحكي حكاية أو تختبر إحساسًا، هذا إن لم تفتح خطّ إنتاج له صيغة ثابتة، وحيث تأتي الأهداف تصاحبها أساليب أقل أو أكثر ميكنة لتحقيقها. لكنّ هذا كله أيضًا جزء من الإطار. بدون ما يحدث بين فم المعدة والقفص الصدري لا معنى لأي كتابة ومع الاعتذار لآلاف مَن تَروج أعمالهم لا متعة في قراءتها. أنتَ إذا كنتَ كاتبًا كما أفهم الكتابة، لابد أنّ لحظة مرّت أثناء النطق أو بعده فزِعتَ فيها من اكتشاف أن محتوى ما تقوله، الأشياء التي تدل عليها كلمات نصوصك في الواقع لا تهم، أو أنها لا تهم إلى أن يُستدَل عليها من خلال كلماتك هذه وعلى النسق الذي صنعتَه من أجلها بالذات. لأنّ القضية كلها في ما يستتبعه ذلك من كلمات أخرى تضيئها وترمي نورًا إلى قدام، ثم الشيء الذي يَنتج عن ذلك ليؤنس قارئه بتحوير الواقع والربط بين أشياء يشير إليها النص وأشياء أخرى في الحياة. أعرف أن هذا يبدو معقّدًا لكنه حسب خبرتي في عفوية وبساطة الحاجة الجسدية، العطش أو الجوع أو الشهوة، وإن كان أعنف وأصعب في تلبيته وأعقد في تجلّيه ومآله من هذه الأشياء.
بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا في قضية الكتابة أستطيع أن أعترف بأنها ليست إلا وجعًا بين فم المعدة والقفص الصدري ينسيك لا جدوى الكلام.
أعتقد أن الوجع هو ما دفعني إلى جعل هذه القضية مركز حياتي منذ سن الثامنة عشرة على الأقل. الوجع الجسدي الناتج عن معاناة نفسية لعلها خلل كيميائي أو فراغ اجتماعي أو أي شيء تافه يخبّئ وعيًا مأساويًا عابرًا لحياة الفرد بل والجيل. وماذا كان يعذبني بين حي الدقي غرب نيل القاهرة ومدرستي الواقعة كما كتبتُ في إحدى أولى قصائدي في ظِل الأهرام؛ كنت طفلًا محبوبًا ولم أكن قد أدركتُ أن صمت وبطء أبي أو نومه الدائم هو اكتئاب. كان فرقٌ طبقي بين البيت والمدرسة، صحيح. كان قلق لم أدرك أنه مَرَضي موروثٌ من أمي. وكان كلام كثير في رأسي لا أعرف معناه عن التاريخ والحقيقة ومعنى الحياة. بين التاسعة والعاشرة أدركتُ أني سمين. في الثالثة عشرة سافرتُ وحدي لأول مرة. كنتُ قد تخلّصت من وزني الزائد ولم أكتسب الجاذبية المرجوة بين أقراني الرياضيين من أولاد الأغنياء.
لكن في السادسة عشرة تفوّقت عليهم جميعا عندما أحببتُ مُدَرّسة الجغرافيا الإنجليزية فبادلتني الغرام. في ذلك العمر تكون الحياة مُثُلًا وطواحين. وكنتُ أكتب عن سبق إصرار وأفكّر في ما يجب أن يُكتب لكنّ النصوص الحية ظلت تلك التي تتدفق من نقطة عميقة في جِذعي بلا قصد ولا فهم سابق لمدلولها. ودونما أستوضح المسألة أو أواجه أسئلة من قبيل كيف تأكل عيشًا وهل للكلام الجادّ في مقتبل الألفية الثانية فائدة، بدا لي أن ذلك النشاط هو سببٌ كافٍ في حياة مجدية ذات قيمة. لم أكن قد فهِمت أنّ ما يُميّز هذه النصوص حقيقة هو أنها تضع الواقع في خدمتها بدلًا من أن تخدم الواقع. وهذا على طرفٍ نقيض من الكلام الذي يَخدع ويؤذي ويتيح للناس أن يستعمل بعضهم بعضًا بأشكال يبدو لي أنها تزداد غباوة وانحطاطًا منذ منتصف التسعينيات إلى الآن.
عندما بدأت لم أكن واعيًا بذلك لكن أعتقد أنه أكثر شيء أقنعني بالكتابة: إنها الحالة الوحيدة التي يكون للكلام فيها سيادة على الأشياء وليس العكس. المساحة التي يتسلّم فيها اللسان صكّ عِتقه من عبودية المصلحة والعقيدة والولاء بل والموت. وكلنا نُضطر إلى أن نموت قليلًا من وقت لآخر كما يقول مولانا روبرتو بولانيو. قال تعالى “وعلّم آدمَ الأسماء كلها”. اللسان بوصفه واجهة التواصل بين الوعي والواقع يبدو لي أهم شيء على الإطلاق. لكن يبدو لي أيضًا أن اللسان خارج هذا الفهم للكتابة يكون منتَهَكًا ومُهانًا إلى أبعد حدّ.
إذن سأصبح كاتبًا لكن ماذا يعني ذلك؟ هل أجد في تلك الصفة خلاصي؟ كانت هناك عوامل أخرى.
كوني ولدًا وحيدًا وميلي إلى الانطواء والتمحيص. سفري المبكّر للدراسة في إنجلترا وصدمتي في الحياة هناك. أو إحباطي مرة بعد مرة وبأشكال مختلفة ومتغيرة في شيء أحسه غاية الوجود كله وباستثناء نفس الوجع في نفس المكان من جسمي لا أستطيع تعريفه أو حتى التعرف عليه: الحب الذي لا يقابله أقل من الامتثال للموت، يتجلّى على هيئة شخص واحد لعله فعلًا لا يُعوّض مهما كان سيئًا لكنك حتمًا تتعذّب إذا رهنت كل حياتك على أهوائه يا صديقي.
أعتقد أن الكتابة كما أفهمها تختلف جذريًا عن تأليف يحقق شروط نوع أدبي أو قضية فكرية، وقد ضحكتُ أكثر من مرة بمرارة عندما رأيتُ كتابًا لي يُقيَّم على أساس اتساقه مع القواعد النوعية للشكل الأدبي المفروض أن ينتمي إليه أو الرسالة السياسية الأخلاقية المطلوب مساهمته في توصيلها. أعتقد أن أكثر ما يُشعِرني بالغربة كشخص يمكن أن يقول إن هذه مهنته هو إصرار الجميع على أن يكون للكتابة استخدام عملي كأن يعبّر النص عن موقف ما من موضوع ما أو أن يباع منه عدد نسخ محدّد أو أن يكون ملحقًا مناسبًا لدور يمثّله كاتبه على المسارح الافتراضية. وكم كرهتُ تجارة الهويات المربحة في أسواق الثقافة الأمريكية.
يبدو لي أن الكتابة في حقيقتها هي شيء بتعريفه ضد أن يُستخدم. إنها تُقرأ بالطبع، لكنها لا ينبغي أن تقرأ بنية أن تدعم فكرة أو تجيب عن سؤال، ولا حتى أن تكشف حقائق قد لا يحصّلها القارئ في مكان آخر. إنها تقرأ لتغيّر شكل الحياة. هل هذا ممكن وإلى أي حد؟ أعتقد أنه حصل معي في الفترة التي أدركتُ فيها أن الكتابة هي ما أريد أن أصنعه بحياتي.
قرأتُ تلك الرائحة لـصنع الله إبراهيم ورواية وجيه غالي الوحيدة، وفي الجامعة قرأت حكاية العين لـجورج باتاي. ولم أعد نفس الشخص ولا عاد العالم ذلك المكان الضيق. طبعًا هناك نصوص أخرى كثيرة من تلك الفترة وفترات تلتها. قرأتُ أشياء غيّرت شكل حياتي بالكامل وطمحتُ إلى تقطير خبراتي بنفس الطريقة لأغير حياة غيري من قبل أن أكتسب خبرات. عندها استقر في ذهني أن عملية إنتاج واستهلاك مثل هذه النصوص هي أقرب إلى لقاء حبيبين منها إلى البيع والشراء. في الحب تصبح شخصًا جديدًا. تغامر بذاتك لتكون مع آخر فيتغير شكل الأشياء. وهكذا الكتابة. في سنينَ تالية عندما أعلم أن أصل معنى كلمة كتاب في اللغة العربية هو رسالة، سأعتنق أكثر من مجاز بريدي حول ما يحدث عندما أكتب ثم يقرأني شخص لا أعرفه. وأستريح لجدوى الكتابة طالما يقرأني شخص واحد.
الآن أعتقد أن الكتابة هي السبيل الأوقع للتفاهم الحميم. سواء أوَجهًا لوجه أو عبر الأثير، عندما يكون الكلام مع شخص بينك وبينه علاقة، مهما حسنت النوايا فإن علاقتكما تنتهكه. لابد من مسافة يخلقها ترتيب فريد لكلمات منتقاة بلا قصد كامل ليتحول وجعك إلى شباك يرى مَن يقرأك من خلاله عالمًا جديدًا. وبصرف النظر عن اضطلاعها أصلًا بالكلام، يبدو لي أن الكتابة مثل الحب فِعل تشبّث مستميت بالحياة في لحظة يتمثّل فيها الموت أقرب وأوضح من كل مآرب الدنيا. وكما أنّ الحب ليس أفلامًا إباحية ولا أغاني عبحليمية بالذات، كذلك الموت ليس البكاء الشَجِن على فراق شخص تحبه يا صديقي. ليس طقوسًا جنائزية ولا غيبيات حتى في أكثر تصوراتها تطوّرًا تظل تدور بغباوة بدائية حول الجزاء والعقاب. الموت هو العدم الأسود الذي يجعل كل طرفة ولمسة واحتمال لقاء كنزًا معجزًا ليس التفريط فيه إلا الكفر نفسه. والحب لا يعدو أن يكون وعيًا صادقًا بالموت. هكذا الكتابة.
أعتقد أن الوجع من بداية الشعور به وحتى يجعل من الكلمات شبابيك عبر رحلة مضنية من جِذع الكاتب إلى دماغ قارئ لا يعرفه هو المحتوى الأعمق للكتابة. طبعًا يوجد موضوع وتوجد لغة، وحتى لو سعى الكاتب جُهده أن يتجنبهما: دائمًا هناك شيء يُكتب عنه ودائمًا هناك طريقة كتابة. المفارق أنّ هذين الشيئين هما كل ما يقال عن أي كتابة حين يقال عن الكتابة شيء، ولعلهما كل ما يمكن أن يقال بالفعل. وكأنّ ليس في الإنسان سوى جسد وحركات أو أصوات تصدر عنه. لكن الواقع أن الموضوع واللغة لا يختلفان كثيرًا عن الغلاف المطاطي للسلك الذي ينقل كهرباءك. المحتوى الأصدق وإن لم يأت ذكره مطلقًا في النص هو الوجع. إنه وجع استحالة الحب وحتمية الموت ووجع نصال تُسقِطها الحياة على رؤوسنا ونحن نمشي في الشوارع، لعل أمضاها كذب مَن نُراهن على صدقهم نافين الدليل الساطع وهو يبهر عيوننا تَعَلقًا بخيال أجدى عن الحياة التي نعيشها عندما نتقاطع مع أجسامهم أو نلاقيهم على النواصي مثل ملائكة ضالّين.
أكثر نَص أثّر فيَّ طوال حياتي إلى اليوم لا أعرف معناه بوضوح: يظهر ملاك إذا تبعته خسرت كل شيء، إلا إذا تبعته حتى النهاية. إنه وجع اللهفة على مَن لا يعمل لك خاطر ذرة تراب وقد غامرتَ بأغلى شيء عندك لأجل عينيه، أو وجع الغُبن الأرجواني عندما لا تأخذ ما تستحقه، أو وجع الإحباط الأخضر في مشروع بدأته وأنت تنوي غزو الفضاء ولم يسفر إلا عن مطعم كشري متواضع. لكن الأهم من كل هذا هو وجع الوجود نفسه يا صديقي. ماذا يعني أن نسكن ليس المكان ولكن الزمن؟ في كتابتي على الأقل، ودونما أتعمّد ذلك أو أعيه في أول عشرين سنةً مثلًا، هناك محاولة مستدامة لمحاكاة ما يعنيه أن تسكن الزمن وهو يتقدم بك ويغير ملامح وجهك ولون شعرك وطاقتك على الحماس للناس والأشياء، وما يعنيه أن يجعلك سكنك هذا طرفًا في مسار التاريخ أو على الأقل شاهدًا عليه.
يبدو لي أن خبرة الزمن هذه هي ما يميز الكتابة ويجعلها أكثر من مجرد كلام وأقيم من مجرد سلعة وأمتع من مجرد منتج ترفيهي يتفوق على المكتوب منه السمعي البصري وتحيله الثقافة الرقمية إلى زمن مفرّغ مثل الوقت الذي يمر وأنت على الطائرة بين مطارين. الكتابة زمن معبأ. لذلك تكتسب أخلاقيتها من كونها لا أخلاقية، وتُحقّق التعاطف الإنساني ليس بالتربيت والتحوير على سبيل المواءمة ولكن عبر نظرة لا يعنيها إلا رؤية ما هناك بكل قسوة وعزوف عن الزيف. هذا إذن معنى البحث عن الحقيقة: الغاية التي تَحضرني بِحِس مفارقة عندما أسأل نفسي لماذا تكتب أو ماذا تعني لك الكتابة. أبحث عن الحقيقة فعلًا. أبحث عن كلمات معينة على نسق تريحني من هذا الذي يبقبق بين فم معدتي وقفصي الصدري كلما عرّيتُ جلدي قليلًا أمام العالم. الحب من أمامي والعدم الأسود من ورائي، وفي المساحة الفاصلة حيث تزل قدمي لأقع وأقوم أو أبحث عن جسم أتقاطع معه من جديد نشاط مجدٍ. معركة حياتي.
——————-
جولان حاجي: نصْلُ أوكام
كان الأسدي متصوّفًا في قراءته العالمَ نصًا مكتوبًا بالأنفاس. بنى مدينته في كتاب، نفخ في صفحاته روحها ولملم شتاتَ الميت والحي من الكلام والبشر….
نصْلُ أوكام/ جولان حاجي
إلى أستاذي الحلبي محمد شهيد نانا*.
عبد الغني
“أنا في زاوية الأمل كراصد القمر”
سورة المدرج [1]
“الله نور”، يردّد الشيخ على عتبة منزله، متأهبًا ليهبط أدراج بناية البستاني، حيث يسكنان هو ومكتبته الضخمة طابقًا كاملًا منها. ساكنًا يتأهّب في العتمة بعدما عاد ليتفّقد ساعة الرمل عند رأس سريره، سرير العازب. تطيّر من نسيانه أن يقلبها قبل خروجه. هسهسة حبات الرمل تؤنس نومه وتقلقه. لا صدى لخطواته في شارع صغير من شوارع حلب التي لم يفارقها قطّ.
“الله نور”، لا يعلم أحد من كتب هاتين الكلمتين على صخرة ضخمة تسدّ الشارع الصغير ووراءها يمتدّ سور السكة الحديدية، ويُسمع قطار الشرق الآتي إلى محطة بغداد، أو قطار آخر ذاهب إلى محطة الحجاز في الشام. لا يعلم أحد من كتب على هذه الصخرة، تحت “الله نور”، بخط آخر أصغر بكثير “والحب عذاب من ذاقه ذاب- أبو حلب”.
تُطمئن الصخرة الشيخ، ويرى في تقاطيعها وجه أبيه عمَر عالم الدين المتيّم باللغة العربية حتى أنه ترجم كنية العائلة من التركية “رسلان” إلى “أسد”. رصّع الابن الكنية بألف لام التعريف والتعظيم، وذيّلها بياء النسبة على غرار المؤلفين القدماء، ثم قدّمها على اسمه ليغدو الأسدي م. خير الدين. القدامى أنداده الحقيقيون الوحيدون. كيف سيبزّ أفذاذ التراث، تجابهه مجلداتهم في مكتبته ليل نهار؟ كيف سيتجاوز كل هذه المؤلّفات التي تجاوره ولا تعرفه، ولدت قبله وسوف تبقى من بعده؟
تتناهى إليه نتف من دعاء المؤذّن في جامع الشيخ طه قبل صلاة الفجر “الليل جنة القلوب”، فتنعشه العبارة كالنسمة التي تلاطف نحره. نحنحة المؤذّن تقبض صدره أحيانًا، كأن الصوت يتهيّأ لينادي باسمه محمد خير الدين ناعيًا إياه وهو لا يزال حيًا، وحين يسمع مكبرات الصوت في جوامع الحيّ تذيع اسم طفل ضائع يرى فيه صورة روحه. جامع عمر بن عبد العزيز على مرمى حجر، لكن نفسه عافت المعابد كلها. لم يُعرف عنه الإيمان بأي رسالة من رسالات التوحيد. هذه ساعة نزهته الصباحية في الحديقة العامة، ووجهته الآن مدخلها الشمالي.
يخشى أن تفسد نزهته إذا قابل مرة أخرى الوجه الكالح الذي أطلّ فوقه فيما هو جالس على مقعد، في الضوء الشحيح، يكتب بخطّه المنمنم المزوّى خاطراً باغته، اعترضه هذا الوجه فجر أمس، مستعجلًا ليكون أول الملتحقين بالصلاة وسأله: هل نهر قويق الذي يشقّ الحديقة تصغير “قاق” لأنه يضؤل في الصيف؟
دفاتر الشيخ وأقلامه الملوّنة مرتّبة في حقيبة يده التي تفوح بصندل مسبحته، واحدة من سبحاته الـ 365. لكل يوم مسبحة تعطّر الزمن وتلوّنه. يخفي القلْبق شيب رأسه وشارباه يغطيان لحيته. عباءته الباكستانية على كتفيه في برد إبريل/ نيسان. لا يزال يؤلمه اختفاء المتسول الذي كان ينام عند تمثال أبي فراس الحمداني، ويغطّي بحقيبته الرمادية المهترئة، الكبيرة كتابوت، اللوحةَ النحاسية المحفور فيها اسم النحات جاك وردة. منذ بضعة أيام، كان قد هُرع إلى الحديقة في الفجر، والبدر ينير الحصى ورؤوسَ الشجر بضوء كالحليب. أتى خصيصًا من أجل هذا المتسول، مصممًا أن ينفحه كل ما معه من نقود. كان مبلغًا سخيًا بعد أن ربح الرهان في “دقّ كونكان”، ولم يتآمر عليه بقية اللاعبين هذه المرة ليغشّوه ويضحكوا منه “يا ميسّر المَيْسر! اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”.
لا خير في فكرة إذا لم تستحوذ عليه كالحمّى. سدى فتّش كالمجنون، كلّ ممشى، كل مقعد تحت أشجار الحديقة الواسعة. أعياه التفتيش حتى توقف لاهثاً تحت شجرة كبّاد، ورمى النقود في النافورة قطعة تلو أخرى، ضاحكاً كلما ارتطمت إحداها بانعكاس القمر في الماء، متخوّفاً من أن تلاحقه لعنة الصدقات الوسخة “يا سين، دنانير تفرّ من البنان، يا سين!” كان عائدًا من ساحة سعد الله الجابري حيث تلا لقلة من مريديه الشبان الذين يسكرون معه مقاطع من “أغاني القبة”. رتّلها كأنها الذكر الحكيم، مجوّداً رافعاً إلى أذنه يمناه، يده الوحيدة، ومغمضاً عينيه. يقول إنه شعر مقطّر كروح الخمر، أصغر جرعاته تسكر أعتى النفوس. بين عديد المفاجآت التي تبهج مريديه وطلبته، بخاصة مَن يزوره للمرة الأولى، إناءٌ غطاؤه فولاذي مسطَّح ذو مقبض، يغلي فيه الماء حتى يقطر البخار على سطح الغطاء المرآة فيلملم القطرات ويرتشفها “آه.. نقية كالدمعة”.
لن يمضي سحابة نهاره غريق كتبه ودفاتره ما لم يحدّد الطريق الأهون للوجبات. سيمرّ تحت الغرفة الصغيرة التي سكنها قرب شارع بارون بعد موت أمّه، ذاهباً ليتناول فطوره المبكر طبقَ مامونية في باب الفرج، موصيًا الحلواني “من طرف الصينية اللي ما فيه دِبّين”. غداؤه طبق صغير من السفرجلية في مطعم إستانبول حيث يخاطبه صاحب المطعم عبد الغني أفندي منذ سبعة وعشرين عامًا ولم يصحّح الخطأ قطّ. من يدري، ربما هذا هو اسمه حقًا.
استراحة العصر مقهى السندباد، الأهدأ من مقهى أفاميا أو مقهى البلور في الجميلية الذي لم يألف بعد اسمه الجديد “العطري”، وقد لا يألفه أبدًا. يضع النادل كاس الشاي أمامه عابقاً بالهيل “تفضّل أستاذ خير الدين”. في برنامجه الذي تبثّه إذاعة حلب مساء كل جمعة “أنت تسأل عن حلب ونحن نجيب”، أجاب الأستاذ على سؤال أحد المستمعين حول كتاب رواتهُ نساء واسمه كتاب اللبّاد، وكان حفيف الأوراق مسموعًا عبر الأثير حين قلّب العلّامة بيده الوحيدة صفحاتٍ من موسوعة حلب المقارنة في مخطوط من مخطوطاتها العديدة، مجلّد أوراقه كبيرة كأوراق الصحف “كتاب اللبّاد كتاب وهميّ لا وجود له متحوّل المحتوى، يتضمن المعتقدات الخرافية لنساء حلب، ويزعمون أنه كان سِفرًا ضخمًا ثم احترق وبقي منه صفحة واحدة سطَتْ عليه الأرضة، بقي منها جزء ما في صدور النسوان. السادة المستمعين، إليكم بعض الأمثلة:
إذا تعذّبت المرا في الطلق بكون عمر ابنا طويل.
المفطوم إذا أكل عسل بخرس.
إذا حكّتك أجرك بكون بدّك تدوس أرض جديدة.
اللي ببرك وبحطّ إجر فوق أجر أمّو بتجيب عجل.
البحرّك النار بالسكّينة بتنجرح أدنو”.
سيتحلّق جلساء الأسدي حول طاولته، بظرفائها وثقلائها، فيلزم الصمت غالبًا وهم يتبادلون الأخبار والنكات. لا يحدّث الحكّاء اللوذعيّ أحدًا عن مشاغله. المقهى مكتبه حين يعود من جولات الشوارع ولقاءات الناس ومعه المواد الخامّ لموسوعته. يتعوّذ حين يلمح وراء زجاج المقهى وجهَ المجيكرجي بغبغب ديك رومي وعيني ثعلب. هل مرّ هذا الوجه فعلًا أم تراه طيف من أطياف عذاباته يلاحقه من مقهى لآخر؟ لم يخطر للأسدي قط أن ديوانه الوحيد أغاني القبة، بالطبعة الفاخرة لمنشورات الضاد، خلاصة عمره ومعارفه وأرقه ونشوته، مدرسته الجديدة في الشعر، سيُهان هكذا أمام روّاد المقاهي، بيدين فظّتين لزبونٍ وقح ولسان قميء يشوّه كلمات قصائده التي اقتلعها من روحه كلمة كلمة، سكنت عقله أعوامًا حتى انتقاها وصفّفها وأهلك عينيه في صقلها.
لم يصدّق أذنيه وعينيه حين قلّده المجيكرجي أمامه، متهكّمًا محرّفًا ما قاله في مقدمة ديوانه “بسم الحبّ، نستقبلكم في مدرستنا الجديدة”، وراح يتلو كالمقرئين نفحات صوفية من الشعر المنثور. الجحيم هي الاحتقار، لا أفدح من وطأته على الروح. سكت الأسدي متعزّيًا بالقرآن “وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا”، وأخرج المغلفات البيضاء والطوابع التي اشتراها لمراسلاته التي يستفسر فيها المستشرقين والفقهاء شرقًا وغربًا، ثم فرد على الطاولة بضعة دفاتر صغيرة وراح يرتّب متطايراتٍ لملمها أثناء تدوينه، بالورقة والقلم، مشاهد أعراس في حلب. سجّلها ورسمها بأدقّ التفاصيل، وقال عمّا كتبه، كأن الكاتب شبحُ غائب “سهر الليالي وتعب النهارات حتى سوّى هالعرس المطنطن”. الشيخ عاشق المسرح أدّى وحده هذا العرس بجميع أدواره، وبثت إذاعة حلب التسجيلَ بصوته الذي يقال “إنه غريب، وجرسه أحد مظاهر شذوذه”.
الرافضي
“لا تشكُ دهرك، لقد طُبعتَ على غير سُننه، وحسبك عنده منار العلم، وعطر النُّبل جريرة وذنبًا”.
سورة الحكمة
“أنا جهاز التصوير أصوّر القصر والكوخ كما هما عليه”، يقول الأسدي في مقدمة موسوعة حلب المقارنة، المطبوعة في سبعة مجلدات بعد وفاته بسبع عشرة سنة، وهي تحوي عشرات الآلاف من المفردات في لهجة حلب عديدة اللغات. أعاد بخطّ يده الوحيدة كتابة صفحاتها التسعة آلاف أربع مرات، و “استمهل عزرائيل” ليضيف إليها 700 صفحة على فراش مرضه الأخير في المبرّة الإسلامية “ولولا أنّ الشمس آذنت بالغروب لأطلتُ أيضًا وأطلت. يا صاحبي القارئ أهمس لك أني وحدي.. وحدي” أهذا ما يصنع الشهداء، وقد تخطّوا الحزن والفرح والذمّ والمديح والإعجاب والإهانات؟ بدلًا من تكرار الكاتب ما يكتبه، لِمَ لا ينخرط في مشروع لا نهاية له؟ هذه المشاريع التوثيقية غير منتهية بطبيعتها، غالبًا ما تراود الشبّان وسرعان ما يتخلّون عنها، غير أنّ الأسدي بعناده المعهود انكبّ وحده، وحده تمامًا، على التجميع والتدوين خمسين عامًا حتى ألّف هذا العمل الضخم، جامعًا فيه بين المعجم والموسوعة وطعّمهما بشذرات من سيرته الذاتية، متنقلًا من أدقّ تحليل لغوي نبشه من بطون أمهات الكتب إلى أمثال الحلبيين وأحاجيهم وأغانيهم وخرافاتهم وعثرات أقلامهم وتفسير المنامات وحتى نداءات الباعة الجوّالين ومصطلحات الحماماتية ونهفات المجانين، فهذه كلها قطع فنية ليست ممهورة بأيّ توقيع. لغة الموسوعة طيّعة واضحة هجينة قد تذكّرنا، في غير موضع، بألف ليلة وليلة. صنّف المحتويات وفق خمسة وخمسين فنًا من فنون القول في حلب، ورتّبها أبجديًا وفق اللفظ الذي يستخدمه عامة الناس.
كل مدينة مدن والكاتب أحيانًا فوج من الكتّاب. مَن الأقدر، سوى اللغة، على احتواء كل شيء إنساني ممكن حتى الآن؟ الحياة مثل الكلمات تسيّرها قواعد النحو والبلاغة. الكلمة رحلة لا تنتهي وأسطورة تُعاش يوميًا، وكل ما يُرى رمزٌ وحقيقة. كان الأسدي متصوّفًا في قراءته العالمَ نصًا مكتوبًا بالأنفاس. بنى مدينته في كتاب، نفخ في صفحاته روحها ولملم شتاتَ الميت والحي من الكلام والبشر، المهمَل والمعروف، ضابطاً فوضى العالم بفوضى الأبجدية. كان الشعاع الذي شقّ أفواه المتقوقعين في مدينة قلبه حلب فأنار أزقتها بلآلئ الكلام وعيونه ومبتذَله، مغطياً بما سمّاه “علم الحياة” تراكمَ الأزمان فيها. استدرك السيَر المحرّمة والبذاءات في مخطوطين مفقودين هما فوات موسوعة حلب وذيل فوات الموسوعة، اختفى معهما ثبت المصادر.
قد يُعاب على أسلوب الأسدي في الشعر المبالغةُ والتصنّع والتكرار، وقد يُرى مجرّد جامع يصنّف أقوال سواه وإضافاته الشخصية قليلة، أو رومانسيًا متأخرًا أبقى ما في قصائده الاقتباساتُ، أحلَّ الفنَّ محلَّ الدين فتكلّف نثراً غنائيًا سمّاه شعرًا وعوّض بالسجع حرمانه من شرف الموسيقا. ليسوا قلّة الذين شهّروا به بين المتأخّرين والمتقدّمين من أدباء حلب، فقذفوا سلوكه بالشذوذ وغرابة الأطوار وعزوا عزوفه عن الزواج إلى المثلية وحبّ الغلمان، واتهموه بالشعوبية والتخريب وانتهاك المقدّسات والعمالة والتشكيك في المسلّمات المتّفق على أصالتها. كسرت شكوكه باب الأصول الموصد على الفخر والهجاء، في مدينة مثل حلب مثقلة بالتاريخ ومكتنزة بالإسلام يُقال إنه ردّ بمزحة حين حسبوه شيوعياً هدّامًا “يا عمّال العالم صلّوا على النبي”.
لم تغفر له أفخاذ من قبيلة الأدباء أن يناقض نفسه بالقول “أنا حلبي من سبع جدود، وسابع أجدادي انكشاريّ” ثم يشكّك في مناسبة أخرى “إن صحّ أني حلبي”. لم ينقطع تأرجحه بين فصيح القول وسخيفه “من الأدب الرفيع إلى الأدب الرقيع”، من أبراج الصمت في أغاني القبة إلى شوارع الموسوعة ونفائس ما لملمه من أيام الناس حيث شعر الحياة الأبقى ودهاء الشفاهة وسفاهتها، حيث الجمال الذي لا يُعرف له نسب أو أصل. لم تكن نخبويته، إذا صح التعبير، استصغارًا للعامة؛ كانت غربته عن نفسه والوجود كلّه. عاش متنسّكًا ومتصعلكًا، بين الخاصة والعامة، فأطربه كلام المجهولين والأعلام سواء بسواء.
لم يُغفَرْ له ترحيبه بمفردات مولّدة أو دخيلة أو معرّبة استخدمها حتى في الشعر، فقد خلخل بهذا النشاز تآلف الأقدمين. رفض المجمع العلمي العربي عضويته رغم إقرارهم “علوّ كعبه في علوم اللغة”. حزّ في قلبه هذا الرفض. لعل العقبتين أمام انضمامه كانتا: أولًا إصراره على أنّ العامية تطوّر طبيعي للفصحى التي ظلّ متشبّثًا بتدريسها ونشر حبها، وثانيًا مقارناته الدؤوبة بين العربية واللغات السامية، إلى جانب لغات المنطقة كالتركية والفارسية والكردية ولغات أوروبية، وفق منهج في الصرف المقارن اعتمده على امتداد بحوثه اللغوية كلها.
أخذ على اللغويين العرب تقاعسهم عن مقارنة لغتهم بأخواتها في جمهرة اللغات السامية، سيّان البائدة منها أو الحية، لإيمانهم بقدسية هذه اللغة وتفرّدها، إذ ليس كمثلها شيء، وإعجازاها القرآن والشعر لا يجوز عليهما النقل والترجمة. لم يعتبر المحكية خطأ وخروجًا عن صراط الصواب، ورأى أنها تحيي اللغات الميتة وتبقيها قيد التداول. الشوائب ضرورة تعفي الجسم من أمراض الوراثة. لم يذهبْ مذهب الكسائي في لحن العوام “اختلاط العرب بغيرهم من الأمم المجاورة أدى إلى فشو اللحن وكثرة الدخيل”، بل اقتدى بالجاحظ الذي كتب عند نقله نوادر العوامّ وأخبار الحمقى في البيان والتبيين “لا تتخيّر لها لفظًا حسنًا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها”.
نشأ الأسدي على تعدّد اللغات في حلب وعاش تزاحمها وتلاقحها. كان احتكاكه بها واقع أيامه ولم يسلّم بشقاقها. آمن أن للغات مرجعًا واحدًا مهما تعدّدت أشكالها، كأنها أرخبيل يجري بين جزره ماءُ اللغة الواحدة المفقودة. لم يرضَ بالإذعان لطغيان لغة واحدة، حتى لو افتتن بسحرها. نثر الله الجمال في اللغات كلّها مشتتًا كاليهود، فلماذا تجميع بقاياه في لغة واحدة وحرمان بقية الأصقاع منه؟ أفحم الأسدي الذين حاججوه بنزع العروبة عن مدينته “دعوني وأوهامي، فإن اللغة العربية أوسع من العروبة”. لم يكن يضع صفة “العربية” في “الجمهورية السورية”، ورفض مرتين تغيير أسماء القرى المحيطة بحلب: مرة مطلع شبابه في حلب العثمانية حين طالبه الاتحاديون بالمساهمة في تتريك تلك الأسماء، ومرة ثانية حين طُولب بتعريبها إبان حكم جمال عبد الناصر في سوريا، فكتب للزعيم المصري رسالة اعتذار معلّلًا رفضَه التكليفَ بأن مثل هذا العمل تشويه لحضارة المنطقة.
مال اليتامى
“هبطتُ هذا الملعب فوجدتني غريبًا وحيدًا”.
سورة السواجي
الكلمات رئات الأسدي وسجونه، أفنى سنيّه في مطاردتها ونقلها وتصنيفها. سلك أضيق الدروب، وسدّد ثاقب نظرته إلى كوّة الكلمة الواحدة أو طاقة الحرف الواحد، ففيهما يجد مرامه: كلّ شيء ولا شيء، وكأنهما خلاصة اللغة بأسرها. نقّب عن جذور كلمة “السماء” في كتاب كامل”عالجناها ككائن حي خاضع لنواميس الحياة”. انتقى إبرة “الألف” لكتاب آخر، وأدخل من سُمّها ناقةَ التفاسير لتخبط عشواء في صحراء اللغة وليلها، ساخرًا ممّن يعتبر اللغة العربية سليلة الصحراء وحدها. كالنحاة القدامى استنبط مسائل كثيرة من ألفاظ قليلة. تجاوِر الكلمة كلمة أخرى فتتواشجان أو تنفصلان وتكرّ السبحّة على أرض الكلام حتى تأتي كلمة أخرى تحتويها، فالكلام الطويل كلمة أيضاً، والكلام في المعجم ما غلظ من الأرض.
الاشتقاقات والمطابقات شغلت النحاة دومًا، وكأن الكلمة منبت الحقيقة. يخرج القراء من رحلات الأسدي اللغوية مشوّشين وقد أشكل عليهم الأصل وازداد التباسًا، إذ لازمه هوس الوصول إلى أصل الكلمة بأيّ ثمن، ليطمئنّ ببلوغه واحدَ البداية أو صفرها، ولا شيء بعد ذلك غير الصمت والفراغ. كان يحفر في أساسات الكلمة حتى تنهار ويضيع القارئ بين شظايا مراياها. هكذا ينقلب الأصل إلى احتمال من الاحتمالات ويُجرَّد من سطوته، ويصير التراث “مال اليتامى” كما سمّاه القرآن. لكأن شاعرًا مثل الأسدي المأخوذ بلانهائية المقارنات يرمي إلى تعميق الينبوع الذي عثر عليه في نفسه وغرق فيه، ذهابًا بالكلمة إلى أقاصي اللغة لتسبح كاللقيطة في العماء. نرى على هذا الطريق الشائك كثير التشعّبات كيف تتعدّد أنساب الكلمة حتى يستحيل القطع بجذر وحيد لها. فلماذا التشدُّق بالأصالة والجذر الثلاثي في القواميس العربية هو الفعل لا الاسم.
قيّاف الليل
“ها يلمس بنان الشعاع الطري بلور نافذتي، وها تطلّ عينه الدامعة على أطلال ليلتي”.
سورة الشظايا.
ذكر الأسدي في كتابه يا ليل (1957) أن “العرب يحتفون بالليل أكثر من النهار كأنما النهار عندهم وسيلة لا غاية، وسيلة لغاية نعمى مباهج الليل ومفاتنه”. جمع في هذا الكتاب 26 رأيًا ومذهبًا لتفسير “يا ليل”، مفنّدًا إياها ومضيفًا بعضًا من اجتهاداته دون الجزم بأيّ منها “وأدعم العظام وأكسو العظام لحماً ثم أنفخ فيها من روحي”. راسل فقهاء اللغة وسافر إلى أكثر من بلد بحثًا عن هاتين الكلمتين “يا ليل” بحثَ التائهين عن أنسابهم المضيَّعة، حتى أنه سأل عنهما مجنونًا في مستشفى الدويريني فأجابه “بونجور يا عيوني”.
إنما المرء بخفيفيه ظلّه ودمه.
فلنسترجع احتمالًا آخر للتسمية لم يذكره الأسدي وقد لا يستهويه. الليل امرأة. أحد جذور “ليل” العبرية هو ليليت التي تضرّع إليها اليهود في منفاهم البابلي. ترجم فان دايك “ليليت” إلى “الليل”: “وهناك يستقرّ الليل ويجد لنفسه محلًا” (سفر أشعياء، 34:14)، وهي في التلمود زوجة آدم الأولى. تخيّل الشعراء أنها الحيّة. بعدما خلق الله حواء انتقمت ليليت بإغواء غريمتها لتتذوّق الثمرة المحرَّمة وتحبل بقابيل الذي سيقتل شقيقه. القرون الوسطى غيّرت مجرى الحكاية. تحوّلت ليليت من حية إلى روح من أرواح الليل متناقضة الأدوار، لتكون تارة ملاكًا يرسم مصائر الناس منذ قذفهم في عتمات الأرحام، وطورًا شيطانة توسوس المسافرين وحدهم في الدروب المظلمة الخالية، أو ترتمي على مَن ينام وحيدًا في غرفة فإذا احتلم أنجبتْ من نطاف احتلامه أولادًا، وتارة ثالثة غولة أو بومة يؤذَن لها في طيرانها الصامت باختطاف الأطفال “أولاد الحرام” وقتلهم. كان يهود شرق أوروبا يعلقون تعاويذ طردها في غرف النوم، ويقولون إن النائم إذا ابتسم ليلة السبت فهذه هي تستدرجه. بمرور الزمن صارت ليليت امرأة طويلة صامتة ذات شعر طويل فاحم السواد، سهامها النيازك تخطّط غرّتها بالشيب وغبار الشهب ذرور لقروح العشّاق تشفيهم لأنهم مثلها بقايا نجوم.
إنما المرء بخفيفيه ظلّه ودمه. لم يطق الأسدي مع جهامة الجدّ صبرًا، لا في حياته ولا في مؤلفاته، فتغلّب على ملله الشخصي أولًا قبل تفكيره بملل القارئ. استطرد في تعليق على تصاريف “يا ليل”، ذاكرًا واحدة من رحلاته الأوروبية رافقه فيها نفر من طلابه الذين أجبرهم دومًا على التحدث بالفصحى أثناء الدروس، وحاول أن يذلّل لهم مصاعب البلاغة ومزالق الهمزات وألّف لهم كتابًا في التربية الجمالية اللغوية هو البيان والبديع (1936)، خلاصة تجربته في معهد التراسنتا لدير الرهبان الفرنسيسكان، إحدى مدارس حلب العديدة، ثانويات وإعداديات، التي تنقّل بينها معلّمًا للغة العربية منذ أوّل شبابه حتى وفاته سنة 1971؛ طلابه “أرادوا أن يفكهوا بحديث اشتقاق المدن التي كنا نزورها، اشتقاقها على أنها عربية النِجار”، فقال أحدهم “أصل بودابست أن بودا الهندي زار هذه البقعة وآذاه مواء الهررة، فكان يزجرهنّ قائلاً: بِسْت، فسميت بودابست”.
التوأم
“أنزع عن وجودي نحاس الوجود، لأغدو ذهب الله بكيمياء حبّه”
سورة الحَبرة
تسلّم الأسدي أمانة السر في جمعية العاديات في حلب سنة 1950، ومقرها دار الكتب الوطنية التي اقتنت في حياته مكتبته الأولى الضخمة، فتلاقى هناك هوساه: الكتب والآثار. عاش من أجلهما. لم يكن يفوّت رحلة من الرحلات التي تنظّمها الجمعية لزيارة بلدات سوريا وقراها، كما شغف بحملات التنقيب الأثرية في بلاده ولاحق أنباءها. حلّل أسماء القرى في جبل سمعان، حيث سمع أكثر من مرة عن كتابات الغنوصيين السوريين الذين بادوا وأبيدت أعمالهم. حواء في كتبهم هي النبي الأول والغنوصية الأولى لأنها أول مَن تذوّق الشجرة المحرّمة، لقّنتها الحيةُ المعرفةَ الخفية وأغرتها بالتألّه. للأسدي آراء أخرى في هذا الصدد، عرضها باستفاضة في مخطوط كتابه “الله” غير المنشور، وفيه يشرّح دقائق كلمة “الله” وصرفها وتاريخها والاختلافات الكثيرة حولها، من قبيل أن الأصل “ولاه” من الوله، أو “الأله” أي التحيُّر، “ومعظم ما يضطرب فيه اللغويون هو في مضموم الأول ومكسوره”، أما “الحيّة” و “حوّاء” فيجتمعان في المعاجم مع “الحياة” و”الحياء”. الخوف أوضح ما انطوت عليه نفوس العابدين حتى الآن، ولهذا سُمّيت الحيّة في العربية “اللاهة”.
ظهرت الغنومات للمرة الأولى في كتابات الخيميائي السويسري باراسلسوس، وبمقدورهم النفاذ عبر الأرض الصلبة كما السمكة تخترق الماء. اسمهم مشتقّ من الـ”غنوص” اليونانية أي المعرفة، يعرفون مكامن المعادن الثمينة حارسين كنوزها في الأرض، ولملكهم الشيخ سيفٌ سحري مصلّت على رؤوس الحزانى الذين تمنحهم كتبهم الخيبةَ والعزاء. الغنومات يقِظون ذوو قامات قصيرة ولحى كثّة وثياب بنّية ضيقة وقبعات كقلنسوات الرهبان. ما أشبههم في هذا التوصيف بالأسدي الذي كتب في مطلع إحدى سوره: “أنا خازن كنوز الحكمة، أنا أُخَذُ السحر” (سورة البيان)، هو الباحث عن حجر الفلاسفة في اللغة بحثه عن الله في كلّ شيء، وآنسه حديث قدسي: “كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعرَف فخلقتُ الخلق وبه عرفوني”.
ربما اغتبط الأسدي وابن عربي إذا قلنا إن الله امرأة لأنها خَلقت حواء أولاً على صورتها “أنا أنتِ وأنتِ أنا/تكونين أينما أكون/أنا الموجود في كل شيء/وأنتِ على صورتي ومثالي/ما شئتُ وعلى أيّ وجه رغبت/أنتِ شبيهتي وأنت توأمي”. هذا ما نقرأه مترجمًا في “إنجيل حوّاء” الذي لم تتبقّ منه، مثل كتاب اللبّاد، إلا ورقة واحدة. الفضل في هذه النجاة عائد إلى رافضي هذا الإنجيل بين آباء الكنيسة الأوائل، وتحديدًا إبيفانوس الذي استشهد بها حين كتب خزانة الدواء مقترحاً فيه علاجاً شافياً للهرطقات كلها.
الأوّل
“تاريخ الدنيا رُفات الأحلام في مقبرة النسيان: يبتدئ في التراب، وينتهي في التراب”.
سورة الحكمة
لم يقرأ الإنسان جميع الكتب السماوية، وعددها في حديث نبوي مائة وأربعة. الله كاتب مقلّ في التأليف، آثر الصمت بعدما اعتزل الكتابةَ، أو بالأحرى إملاءَ الكتابة، ولم يُتح لعامة القراء إلا أربعة من كتبه.
يذكر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان أنّ “آدم أول نبي مكلَم. أنزل عليه الله إحدى وعشرين صحيفة أملاها عليه جبريل وكتبها آدم بخطه بالسريانية”. ثم ينقل عن الطبري “أول ما أنزل عليه [آدم] حروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة، وهو أول كتاب كان في الدنيا”. يخالفهما أبو إسحاق الثعلبي، ويقول إن آدم أجاد آلاف اللغات، أفضلها العربية، وعلّمه الله الأسماءَ كلّها حتى الفسوة والضرطة.
يؤكّد حديث نبوي “ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان”، وفي حديث آخر ضعيف إن الله خلق مائة ألف آدم، فكتب المعرّي “جائز أن يكون آدم هذا/قبله آدم على إثر آدم”. ابن عربي خالف الجميع وقال إن أول المخلوقات محمد، سبق خلقه الكونَ كله، وإن القرآن هو محمد مَن نظر إليه رآه فيه.
آدم يحقق ما يقول الشعراء ولا يفعلون، أي أن حقيقة التجاوز تجاوز النفس. لا أحد من أمامه ولا من خلفه. لم يتأخّر عن أحد ولم يسبقه إلى شيء أحد. لا أحد سواه ليحسده أو يغبطه، يعلّمه أو يتتلمذ عليه. لا خوف من سرّاق الأفكار. لا شبهات ولا ريب. لا منافسون. لا طعنات في الظهر. لا ندم. لا وحشة. لا بكاء على الأطلال. لم يقتل أحدًا ليبدأ التاريخ به أو بالقتيل. بداية التاريخ سيرة شخص وحيد مطرود من جنته حديقة بيته، ثم صار أول المفجوعين بمقتل ابنه على يد شقيقه وأول مَن قال شعرًا فرثى، والرثاء أمّ الأغراض الشعرية كلها، وإن تبرّأ الشاعر الأوّل لاحقُا من القصيدة الأولى في العالم، فالأنبياء أكرم من أن يكتبوا شعرًا. حنين آدم إلى الفردوس شوق إلى بسيطة البدايات، إلى الانبساط في باء البيت وباء الحبّ. ما أهون التفكير وقتذاك، وما أخفَّ ماضيُا عمره يوم واحد أو أسبوع واحد.
الرفاق الطليعيون
“لا زهو، يا نفسُ! ولستُ بزاهٍ، وأي زهو. لقطرة نثرها الموج إلى صخرة. وما كادت تشعر بالوجود، حتى لحقت بالسحاب؟”
سورة الحكمة
اجتاز الأسدي حربين عالميتين وشهد استقلالين سوريّين. هذا الرجل “الوديع الهادئ”، “الشيخ الطفل الغريب” على حدّ وصفه نفسه، ممسوس بنار الكلمة لم يفارقه هوسها طوال حياته، في صمته وخلواته ومخالطته للناس. لم أجد ما يدلّ على اكتراثه بأن تتبوّأ “أغاني القبة” عرش قصيدة النثر في الشعر العربي الحديث حين طُبعت سنة 1950، ناهجًا في التدقيق والتقديم نهجَ القدامى، ربما أسوةً بالمعري الذي صدّرتْ مقدماتُه كتبَه كلها. يبدو لي هذا الديوان نهاية عصر لم يبدأ منها أحد في الدائرة السحرية الملعونة للكتابة.
في اعتقادي، المحدود بما استطعتُ العثور عليه من متفرّق المقالات في الضباب الذي يلفّ جوانب عديدة من سيرته ومخطوطاته ومصيره، لم يعبأ الأسدي بريادة الشعر. لم يعبأ بمن انبرى لتحريره من الأوزان أولًا وأيّهما الأسبق: كوليرا الملائكة أم أزهار السيّاب الذابلة. ما همّه أيّ المدينتين أثرى وأيّهما أولى بوسام البدايات التي أسّست لحداثة الشعر العربي: حلب أم بيروت؟ ومَن سبقه مِن الفحول إلى بكارة البواكير، ومَن حمل لواء قصيدة النثر العربية الحديثة: هو أو محمد الماغوط أو أنسي الحاج أو توفيق صايغ…؟ ومن اقتدى في التنظير لها بسوزان برنار أو استضاء ببودلير أو تورغينيف…؟ لم يأبه بتكريس فلان من الشعراء أو تهميش فلان آخر، ومن صان الإرث ومن أهدره. لا عزاء في إنصاف المستقبل يأتي بعد أن يشبع المظلومون موتًا، فتفنَّدُ ريادة مَن زعموا الزعامة، ويعود الحقّ إلى نصابه، ويُبعَث من جديد أستاذٌ منبوذ أو عبقري مغمور أو متعفّف عن الظهور قد يقرأ معاصروه ومنافسوه في تعفّفه زيفاً أو استعلاء. القصة ذاتها عبر الأحقاب.
لم يخض الأسدي سجالات الشعراء حول أزمة الشعر وما يشجر بينهم في المحافل والصحف من خصومات ونزاعات، يتلاسن فيها بساخن المقالات الماركسيون منهم والليبراليون والقوميون. استعاض عن أوهام جماعاتهم بأوهام وحدته، ولم يلقِ بصخب عزلته إلى جمود صخبهم. لم أقرأ له شيئًا اكترث بتصانيفهم وتثويرهم الشعرَ أو تطويره “من الاتّباع إلى الإبداع”، ومدى صدقهم أو احتيالاتهم ودسائسهم وتنازلاتهم. لم يدخل مراتب سلطانهم وتحزّباتهم لاسم هنا أو صورة هناك، “وكل حزب بما لديهم فرحون” (سورة “المؤمنون”)، “ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك” (سورة “هود”). لم يرَ زمن الشعر زمناً تاريخياً، ولم ينخدع غروره بالجماهيرية ولا بالعالمية، تاركاً الشعر الوطني وقصائد المناسبات لصديقه عمر أبو ريشة.
لا بد من القول هنا أن حلب شهدت ديوانًا آخر متطرفًا ووحيدًا ورائدًا في قصيدة النثر السريالية، سبق أغاني القبة في الطباعة ولم يسبقها في الكتابة. إنه “سورّيال” (1948)، العمل المشترك بين أورخان ميسّر وعلي الناصر، وهما شاعران يجيدان عدة لغات، تنازعهما العلم والأدب، فالناصر طبيب أمراض جلدية قُتل في شيخوخته داخل عيادته، وميسر درس الفيزياء الكونية وانتسب إلى الحزب القومي الاجتماعي حتى لاقى معبودته “سوريا” في “سورّيال”. نقرأ في مقدمة هذا الديوان كيف يحاول الشعر التقاط “ما يرسمه العقل الباطن من صور”، وأن نرى كل شيء قد أصبح شيئاً واحداً “يشعرنا شعورًا واضحًا ودقيقًا بكل كائن ينمو ويتوالد أو يتحطّم ويتحوّل على هذه الكرة الكبيرة”.
*هذه النصوص مقتطفات من دراسة طويلة غير منتهية عنوانها مئة اسم للألم.
[1] المقتبسات كافة في مطالع النصوص منقولة عن أغاني القبة لـخير الدين الأسدي.
————————-
صلاح باديس: الجغرافيا قبل التاريخ
ليست الغابة، وحياة التخييم الآخذة في الانتشار مؤخرًا بالجزائر، سوى مثالًا من بين عشرات الأمثلة لمواضيع المتروكة جانبًا، بل وغير المرئية في بعض الحالات، لصالح مواضيع “تاريخية” تُعني بترتيب أوراق مكتبة الرواية الرسمية للسلطة، بدل ما تحرقها…
الجغرافيا قبل التاريخ/ صلاح باديس
بدأت مؤخرًا أهتم بالتخييم في الطبيعة، غالبًا في الغابات والشواطئ، في انتظار أن أجرّب الصحراء. أما التخييم فهو نصب الخيمة وإشعال النار والبقاء في مكان معيّن، وترافقه نُزهةٌ في المكان لجمع الحطب وربما بعض الأعشاب وملء المياه إذا ما كان هناك غدير، وغالبًا فقط لغرض المشي وفتح الرئتين على هواء الغابة وعطرها.
قبل هذا كنت شخصًا تربى في ضواحي المدينة، لا يتنقّل ولا يهتم بما هو خارجها، يعيش مثل أي صرصار من الطبقة الوسطى يحمي مسكنه ووسيلة تنقله بين الأماكن المغلقة. وكانت الغابة بالنسبة لي مكانًا بعيدًا يزوره الناس فقط عند تساقط الثلج، بما أن أغلب الغابات في الجبال.
ثم، وهذا سبب رئيسي، الغابة تنتمي للحقل اللغوي الواسع لفترة الحرب الأهلية في الجزائر. من يقول الغابة فهو يقول الإرهاب. وهذا ما فكّرت فيه عندما عرض عليّ أصدقاء أن نُخيّم للمرة الأولى، وهذا ما سمعته من أصدقاء آخرين عندما عرضت عليهم بدوري التخييم.
بدأ التخييم ربما، كهواية وممارسة، لدى الشباب في الجزائر منذ سنوات قليلة فقط، دعنا نقول منذ عقد من الزمان، أي بعد سنة 2010. الأكيد أن التخييم في الشواطئ، في فصل الصيف، لم يتوقف، لكن العودة إلى الغابة أخذت وقتًا.
*
يفتح “المنظر” أمام الكاتب فرصًا ومساحات واسعة للكتابة. تلاقي الزمن بالفضاء الخارجي، الهروب نحو التضاريس طبيعيةً كانت أم عمرانيةً، مُساءلة الأفُق في بلاد أغلب من يعيشون فيها نظرتهم مُعلّقة بالأفق.. كل هذا يمنح من يكتُب فرصةً ومسافةً كافيةً للتجريب. الاقتراب من الجغرافيا والخريطة خلال الكتابة لا يعني بالضرورة تكريس الكتابة لوصف المناظر، فنحن لا نكتُب دليلًا سياحيًا ولا نُروّج للحياة في منطقة ما، بالعكس.. هنالك قصص وأشعار تحدث بالكامل في الطبيعة ولكننا لن نقرأ سوى عن “مناظر داخلية” للشخصيات، تُحيلها إليها الطبيعة.
ليست الغابة، وحياة التخييم الآخذة في الانتشار مؤخرًا بالجزائر، سوى مثالًا من بين عشرات الأمثلة لمواضيع المتروكة جانبًا، بل وغير المرئية في بعض الحالات، لصالح مواضيع “تاريخية” تُعني بترتيب أوراق مكتبة الرواية الرسمية للسلطة، بدل ما تحرقها.
*
ليست كل كتابة أدبية تاريخية سيئة بالضرورة، لكن الروايات التاريخية التنقيحية والتحريفية، التي تزوّر الماضي لتأكيد السردية الوطنية وما شابه، ليست سوى فقاعات حكائية لا طائل منها.
لا تكاد تحضر الجغرافيا في الأدب الجزائري، المكتوب بالعربية أو الفرنسية، سوى كاستعارات وتشابيه لغوية فارغة تعبّر عن الجمال أو البؤس. فهناك القرية المهمّشة، والشاطئ الساحر، والصحراء التي يهرب إليها الأبطال لينسوا، والجبل حيث الذاكرة البعيدة، والوديان التي لا نعرف لماذا هي هنا. ولا يعني غياب الطبيعة أن المدينة حاضرة، فشخصيات أغلب القصص والروايات القادمة من الجزائر لا اسم للحيز الذي تتحرّك فيه.
*
مثل السينما والصحافة، وُلِد الأدب في الجزائر كردِ فعل ضدّ الاستعمار، كثورة سبقت الثورة الكُبرى بسنوات قليلة. وُلِد بلغة المستعمر، يحمل مشاكله معه ونبوءاته بما سيكون عليه الحال في المستقبل. من الصعب إلى اليوم على النّاس قراءة أشياء لا “نضال” فيها، بعد أن عوّضت هذه الكلمة كلمة “الكفاح”. من الصعب على أغلب من يكتُب اليوم، في هذه البلاد، ألاّ يشعر بإلحاح خلق سردية جديدة لتاريخ البلاد، مُهمِلا في سبيل إنجاز مهمته النبيلة هذه أن يُساءل ويفكّر في اللغة والشكل والمواضيع الأخرى، مُهمِلًا أن يتروّى ويُفكّر قليلا في تقدّم القطارات أو تراجع موجة البحر.
*
درس شوقي عمّاري الجيولوجيا قبل أن يلتحق بالصحافة المُفرنسة ليصير رسّام كاريكاتير وكاتب تحقيقات وأعمدة ساخرة. أول كتاب قرأته لشوقي، الذي ألّف في القصة والرحلة والرواية والربورتاج الصحفي، هو الطريق الوطني 1 (2007). كل نصوص شوقي تنطلق من رحلة أو سؤال فيزيائي، شخصياته هيئات ساخرة أكثر منها تمثيلات لأشخاص من لحم ودم. لغته الفرنسية المعروكة بالكتابة اليومية في الصحافة أوْجَدَتْ سلالة وركاكة قبل ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، لتسرُد غرابة وعبث جزء كبير من الحياة في الجزائر. في الطريق الوطني 1 يسافر شوقي مع صديقه من العاصمة إلى حدود النيجر مع الجزائر، في أطول طريق في البلاد (2335 كيلومتر) ويسرد لنا المناظر واللقاءات.
أما في الحمار الميت (2014)، التي تستلهم عنوانها من أول رواية جزائرية وربما عالمية الحمار الذهبي لـأبوليوس أو أفولاي باللغة البونيقية، القرن الثاني قبل الميلاد، حيث تُنطق بالفرنسي لان دور L’Âne d’or، وعند شوقي تصير لان مور L’Âne mort، نسافر مع شخصيات شوقي الهاربين من العاصمة إلى جبال منطقة القبائل بسيارة تمشي ساعة وتتوقف ساعة، وفي صندوقها حمار ميّت يجب دفنه. تتساءل الشخصيات، في طريقها نحو القمم، عن الجاذبية والحُب وما هو أقرب طريق لتحصيل المال في الجزائر.
*
تكاد مسألة الشكل الأدبي تكون غير حاضرة في الجزائر. ففي غياب “حقل أدبي” بكل ما يتضمنه من سوق نشر وصحافة مُرافقة ونقّاد، يجدُ الجزائريون والجزائريات أنفسهم يتسوّلون النشر، لمن لا يريد أن ينشر في دور نشر جزائرية مغمورة لا تُوزّع، في المشرق عند من يكتبون بالعربية وفي فرنسا عند من يكتبون بالفرنسية. كل هذه الرحلات التي يقوم بها الكاتب للوصول إلى “موائد الآخرين” تجعله يتنازل عن كثير من الأشياء وإنتاج نصوص مسطّحة: يتنازل عن لغة تخصّه، بل لا يعمل حتى على إنتاجها، فإمّا عربية فصحى مشتركة كي يفهمها الجميع أو فرنسية بيضاء من غير تفاصيل وتراكيب قد تخرج من ازدواجية لغته. ومن حيث الشكل، ينشر الجزائريون بشكل حصري، تقريبا، روايات لا تُزاحمها إلاّ فيما ندر القصص والقصائد والنصوص الحرّة؛ بل لا تكاد تجد أسئلة عن الـFiction والـNon-Fiction، أي الكتابات التخييلية وغير التخييلية. الكثير من التفاصيل المهمّة تضيع في طريقك كي تنشر عند الآخر، كي يستقبلك في حقله الأدبي، مُفردًا لك سريرًا في غرفة الضيوف. لذلك لا “ينجح” الجزائريون سوى بروايات مسطّحة اللغة والشكل، عربيًا وفرنسيًا، وكل مواضيعها تقع في إطار “التاريخ السياسي” للبلاد.
*
الأفُق في اللغة هو خط دائري يرى فيه المشاهد السّماء كأنها ملتقية بالأرض، ويبدو مُتعرّجا على اليابس ومكوّنا دائرة كاملة على الماء. وعودةً إلى فكرة تلامس المنظر الخارجي مع دواخل الإنسان، والشخصيات الأدبية، تقول الآية القرآنية: “سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم”. أمّا في اللغة اللاتينية فيعني فعل horizein “تحديد”، وجاء من كلمة horos وتعني “حد”. ومنها جاءت الكلمة الحديثة horizon التي لم يكُن لها معنى في علم الفلك القديم سوى: ما يحدُّ الرؤية.
*
قبل سنوات، بدأت مع صديقتي المترجمة والشاعرة لميس سعيدي، بترجمة عدد من الشاعرات والشعراء الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية، من الستينيات إلى التسعينيات. كانت ترجمة آلية، دفعنا إليها اكتشافنا لهاته القبيلة الواقعة في منزلة بين المنزلتين، بين الجزائر التي لا تقرأ شعرهم، ولا تطبعه في أغلب الأحيان، وفرنسا الحل والمشكل في الوقت نفسه، حيث إنها تطبع كتبهم وتمنح بعضهم اللجوء والخلود المؤقت بعد الموت ولكنها، لأنها هي، تجعل لهم عظامًا في ألسنتهم التي يقولون بها الشعر.
الفكرة التي توضّحت مع الوقت، وواصلت فيها لميس لاحقا بدأبٍ وذوقٍ عالي تُجاه اللغة، هي نقل الحساسية الشعرية التي صنعها شعراء بلدٍ، لم تكُن نُخبه التقدمية وقتها تُتقن اللغة العربية، إلى اللغة العربية التي نكتب فيها هي وأنا وأغلب الأجيال الجديدة اليوم.
مُحاولين الإشارة إلى دروب موجودة، ولكن قليلين جدًا من اهتموا بها وقلّة منهم مشوا فيها، ترجمت لميس آنا جريكي المجهولة، ورابح بلعمري ويوسف سبتي ويامينة مشاكرة ومالك علولة، في حين اهتممتُ أنا بـجان سِناك وحميد سكيف وآخرين.
جان سِناك، ابن العاملة الإسبانية من وهران والولد الذي لا يعرف أباه ويصاحب العرب، كان في قصائده الغزيرة، خاصة تلك التي كتبها بعد الاستقلال، يُسمّي كل ما تقع عليه عينه، من اللامرئي إلى الملموس، من المشاعر والحركات إلى التضاريس والجغرافيا.
تقول الباحثة الفرنسية هيلين بْلي، في كتابها سرابات الخريطة: اختراع الجزائر الكولونيالية، إن الطوبوغرافيين الذين رافقوا الحملة الفرنسية بعد 1830 إلى الجزائر، كانوا متأثرين بالتغييرات التي حملتها الثورة الفرنسية إلى مجالهم: تسمية تضاريس الإقليم حسب ما فيه من وديان وعيون وجبال إلخ لتعويض أسماء النبلاء والدوقات والأمراء التي شاعت لقرون. وكذلك فعلوا مع إقليم لا يعرفون له شكلًا ولا اسمًا، وقضوا عقودًا يخترقونه ويرسمونه ويطلقون عليه أسماء أجنبية أو أسماء تتعلّق بالوديان والجبال القريبة بعد أن حطموا نظام القبائل والعروش ليجرّدوهم من أراضيهم.
سِناك كان يُدرك كل هذا، ولذلك كان مُهمًا بالنسبة إليه أن يُعيد تسمية الأماكن في قصائده، ولأنّ الشعر ليس صورة واسما فقد كان سِناك الشاعر الجزائري ذي الخط الفرنسي، كما سمّى كل من يكتب بالفرنسية، يصفُ لنا بهاء الألوان والطبيعة في كل أكثر من مكان، من “الحاجز الحجري لشاطئ بولوجين” وحتى “الآن ولأجل أولادنا أقول لون طولقة/ ذاك الأزرق الذي جاء يدُقّ على نافذتنا/ ليس أزرق البحر ولكنه سرير أعمق/ لأجل تسالي الروح البسيطة/ وقلبنا، مثل لحاف، فرشناه على هذا الأزرق/ (انظري، إنه يلمع !)/ الابتسامة الزرقاء لطولقة من بين أطلالها ونخيلها”.
*
ورغم الحضور الجغرافي لفعل “نزع الاستعمار” منذ عقود، على المستويين الجماعي والفردي، لكنه شبه غائب تقريبًا عن أي خطاب أدبي. وحتى أنصار مذهب “كفانا حديثًا عن الاستعمار ولنلتفت إلى حاضرنا ومشاكله”، لا نجدهم يهتمون بالجغرافيا التي يعيش فيها الإنسان، بقدر اهتمامهم بتحليل توجهاته وأسئلته ومُسلّماته. فمثلا: الجميع يتحدّث عن ثنائية الدين والعلمانية ولكن لا أحد تقريبًا يذكر الحيّز العام الذي يلتقي فيه المتديّن والعلماني. الجميع يتحدّث عن حرية التعبير والديمقراطية ولكن قلّة من تذكر سياسات الفضاء العام والقوانين المقيّدة له. الجميع يتحدّث عن كيف أن الجزائريين غير متحضّرين ولا يستحقون مدنهم الهوسمانية في حين قلّة من تطرح للنقاش سياسات الإسكان. الجميع يتبارى في السبق للقول من هو الشرير ومن هو الطيب: الدولة ظالمة ومرتشية أم الشعب مش متربّي ولا متحضّر؟ ثورة ثقافية أم ثورة سياسية؟ أبيض أم أسود؟ ولا أحد ينظر إلى الأرض التي نقف عليها.
*
تُعتبر الجزائر بلدًا ريعيًا، يعتمد في اقتصاده ومنذ عقود، على تصدير المحروقات بشكل أساسي. الغاز والبترول هما الضرع الذي ترضع منه الدولة. تقع آبار البترول والغاز في الجنوب، على بُعد مئات الكيلومترات، والآلاف في بعض الأحيان، من الساحل والمدن الكبرى في الشمال. لكن لأسباب تتعلّق ببنية المجتمع وطبيعة الدولة وطريقة توزيع الثروة، لا تُعتبر الجزائر بلدًا نِفطيا (يجب القول، أيضا، إنها لا تُنتج بقدر ما تُنتج دولة كالسعودية) ولكن رغم هذا تبقى كلمة البترول من أكثر الكلمات ترديدًا وشيوعًا في المخيّلة الجمعية. لكن لن نجِد أثرًا لكل هذا في الأدب، هذا ما نبّهتني له زميلتي في الكتابة منى كريم خلال نقاش حول الجغرافيا والكتابة. لن تجد أثرا للبترول في الأدب، لا كواقعية اشتراكية تُرسل أبطال الروايات للعمل في آبار البترول حيث تدور مكائد الشركة الوطنية الكبرى والشركات الأجنبية، ولا كرواية انطباعية تُرسل البطل للعيش في “قواعد الحياة” المعزولة عن العالم، ولا كخيال علمي يُحقّق الجملة الشهيرة للجزائريين عن حاسي مسعود عاصمة النفط “هل تعلم أنّ حاسي مسعود، من كثرة استخراج البترول من تحتها، صارت مدينة تقف على الفراغ”.
*
عن ماذا يكتب الجزائريون إذا لم يحاولوا، مع كل كتاب وفيلم، إعادة رسم تاريخ البلاد القصير نسبيا والتنافس في تكذيب هذه النسخة أو تلك؟ هل يستسلمون لشساعة خريطة بلادهم، ويكتب كل واحدٍ عن مدينته أو ضاحيته؟ يخاف الجزائريون من كلمة “الجهوية”، رغم وجودها في كل مظاهر حياتهم من الموسيقى إلى الأكل واللباس، لكنها على مستوى الخطاب الرسمي منبوذة، على الجميع أن يكون مثل الجميع، ولا مجال للاختلاف أو التفاوت. ربما لهذا يعجز الكثيرون عن تخيّل أدبٍ جهوي، يخرج من تشابه المنشأ والجغرافيا والثقافة السائدة في جهة ما.
*
هنالك نظرة معلولة مفادها أن الجزائر العاصمة هي المركز، وبقية البلاد أطراف وهامش ومناطق ظل كما تسمّيها الحكومة التي وُلِد نظامها منذ الاستقلال إدارة يعقوبية، تراكم المال والسلاح وسلطة اتخاذ القرار في العاصمة، ويتجاهل الكثيرون أن كل هامش هو مركز له هوامشه وهكذا.. وكان لي الحظ أن أتناقش مع أصدقاء وقرّاء لقصصي وقصائدي، حول تفريقي بين وسط العاصمة وضواحي هذه الأخيرة التي أنتمي إليها، حيث لم يفهم البعض لماذا أرسم خريطة كل مرّة أقصّ فيها قصة، في حين أنّ الأغلبية تعتبر كل ما يدخل في لوحة ترقيم 16 عاصمة ومركزًا.
*
“ليس التفكير خيطًا ممدودًا بين الموضوع والشيء، ولا ثورة لأحدهما على الآخر. يحدث التفكير في العلاقة بين الإقليم والأرض (…) هما مركبان، الإقليم والأرض، بمنطقتين لا يمكن تمييزهما، نزعُ توطين الإقليم من الأرض، وإعادة توطين الأرض في الإقليم. لا يمكننا الجزم بمن يأتي أولًا”. هذا ما كتبه كل من جيل دولوز وفيلكس جواتاري في كتابهما ما الفلسفة؟ (1991).
“نزع التوطين” مصطلح صاغاه معًا، سنوات قبل نشر كتابهما هذا، ويعني نزع مفهوم من سياقه وإعادة توطينه في سياق آخر بشكل يسمح بتفعيل السياق الجديد. وباختصار مُعيب، يمكننا وصف استعمال أداة من الزراعة في مجال الطب، أو مفهوم من الفلسفة في مجال السينما، كنزع وإعادة توطين. ويُمكن القول، في حالتنا الجزائرية، إن الأرض (أو ثامورت كما تُنطق بأمازيغية القبائل) لها حضور كبير ورمزي عند الناس، لكن الإقليم، والحركة فيه، يخضع بالكامل لسيطرة الدولة وريثة جبهة التحرير التي حرّرت الأرض وصادرت الإقليم. وهنالك هُوّة كبيرة في الواقع، وفي تمثيله الفني، بين الأرض والإقليم.. ونحن، ربما، في انتظار حدوث شيء في “المنطقة التي لا يُمكن تمييزها”: إعادة توطين الأرض في الإقليم.
*
يُنبّهني صديقي الموسيقي والباحث أن “الصّح” حول المختلف عليه في تاريخ موسيقى بلاد المغرب، والعالم عمومًا، تجده في تعليقات يوتيوب. ذلك الهامش، الذي يُذيّل الأغاني ويُثني فيه، غالبًا، المعلّقون السمّيعة على المغني ويذكرون بلدهم ويوجهون تحية إلى فلان، هناك تُطرح الأسئلة والأجوبة وتختلط حتى يخرج “الصّح”. وما عدا المعارك الطاحنة بين الجزائريين والمغاربة حول أصول أغنية راي أو مغنٍّ ما، وجد صديقي الكثير من المعلومات الصحيحة حول حياة مغنٍّ مغمور، أو حول واقعة ما كُتِبت بسببها القصيدة الفلانية.
دائما على يوتيوب.. وفي الكثير من أغاني الرّاي، نجدُ أصحاب الحسابات غير الموثّقة، المولعين الهُوّاة، يحمّلون الأغاني النادرة والقديمة بصيغة MP3 ثم يستعملون خيالهم لتصويرها. هنالك مثلا قناة تسمّى Dubisababa تضع خريطة وهران كصورة لنصف فيديوهات أغاني الرّاي. خريطة بلون زهري فاتح، مكتوبة بالفرنسية وتصوّر الطرق والأحياء، خريطة عامّة وليست خاصّة بالموسيقى، بل تصوّر الإقليم الذي خرجت منه الموسيقى. وهنالك آلاف القنوات الأخرى التي تُصوّر الإقليم نفسه، صورٌ كثيرة ليست لمدينة وهران فقط، بل لباديتها كلّها حيث نرى مساحات خلاء ترعى في الأغنام أو أكياس البلاستيك التي تلوّث الطبيعة ونرى أيضا شوارع القرى البائسة والمقفرة، نرى صورًا لمركبات يعشقها سكان الأرياف غرب الجزائر: بيجو 505 طويلة صفراء، شاحنات K66، دراجات نارية بيجو 103. نرى أيضا ديارًا تشارف على الانهيار وطبعا عمارات السكنات الاجتماعية التي تبيعها الدولة بالكراء وتُمثّل لوحدها قمّة “جماليات المعمار الجزائري” في القرن الـ 21.
لطالما حملت أغاني الرّاي تضاريس مؤدييها والإقليم الذي تدور فيه. فإذا لم يذكر المغني الحيّ الفلاني، أو قهوة فلان على الشارع الرئيسي لمدينة كذا، لن يفوته توجيه التحية لثُلّة من الأصدقاء والأحباب في القرب وفي البُعد. سواء من ناحية النصوص وذِكر الناس وأشياءهم وخريطتهم التي يتحركون فيها، أو من خلال الموسيقى نفسها التي يُسمّى أحد مقاماتها: التراب، دائمًا ما يرسم الرّاي خريطته.
هل يعني هذا أن كل من يكتب عليه أن يستعمل الجغرافيا ويحدّد خريطته المطابقة للإقليم ليحصل على اعتراف ما؟ لا، هناك خرائط متخيّلة وعوالم لا وجود لها ولا تحتاج إلى خريطة. الأدب ليس تأكيدًا وهمزة وصل بين الإقليم والخريطة. لكن الجغرافيا تعلّمنا التحرّر من فكرة النوع أولًا.
*
هل تكون الجغرافيا بديلا للتاريخ؟ ليس بالضرورة.
*
يُمكن للجغرافيا أن تُكذّب التاريخ، أو تفضحه، أو تصحّحه وفي أفضل الأحوال تتجاوزه.. كما يحدث دائما في أفلام التشيلي باتريسيو جوزمان، ثلاثيته نوستالجيا إلى الضوء (2010)، زرّ اللؤلؤة (2015)، جبال الأحلام (2019) تدور في مساحات سردية شائكة ومتوقّعة من مخرج في بلد كالشيلي.
فهذا البلد الهانئ منذ بداية القرن العشرين، بعد قرون من المجازر في حق السكان الأصليين، غالبًا ما يُلخّص تاريخه الحديث في محاور رئيسية: ثورة اشتراكية فوصول سلفادور آليندي للحكم ثم الانقلاب عليه سنة 1973 وبداية دكتاتورية عسكرية يقودها بينوشيه ومن خلفه أمريكا والـشيكاجو بويز، ثم مجيء الديمقراطية، ثم فتح ملفات المخطوفين والتعذيب وتحويل الجنة إلى جهنم ثم مقولة “الشيلي هي جنة النيوليبرالية”.
زخمُ حياة كامل، تختصره العين الأجنبية في ثلاثة أسطر.
نفس الشيء مع الجزائر مثلًا، احتلال فرنسي ثم الثورة فالاستقلال ففشل التجربة الاشتراكية فصعود الإسلاميين والحرب الأهلية ثم سنوات الركود وتحت كل هذه الأحداث يجري نهرا الدم والبترول. عودة إلى جوزمان، ولنفترض أنه لاعب كرة قدم، ليس يختار ملعبه، وكرته هي ذكريات الطفولة الهانئة ثم الشباب الثوري قبل بينوشيه ليس لديه الكثير ليعجنه في هذا التقاطع بين الخاص والعام، ولكن جوزمان فنان شاطر، رسم في أعماله كلها وبالخصوص في هذه الثلاثية أجمل خطوط انفلات في السينما اليوم، وقام بأجمل التسديدات. الفيلم الأول عن صحراء أماكاتا في شمال البلاد، الثاني عن المحيط الهادئ، الثالث عن سلسلة الجبال التي تفصل البلاد عن القارة.
*
هنالك كاتب لا يُسهِبُ في وصفِ منظر خارجي، ولكنّ ما يُقدمه من كلام مُقتضب يكفي لإشاعة حالة الجو في القصة، كما توجد كاتبة لا يُمكن رؤية شخوصها كأشخاص بل كمجموعة من المشاعر المكثفّة، هيئات مُلوّنة أكثر منها ذواتًا، ولكن من خلال الاقتضاب واللاّ وصف وعن طريق الهيئة لا الذات، نشعرُ كقرّاء بخريطة وجغرافيا كاملة تكمُن تحت اللغة وفي عمل هؤلاء الكُتّاب؛ هنا تظهر الجغرافيا والخريطة كورشة أدبية كُبرى.
الخريطة بشكل خاص، والجغرافيا بشكل عام، ليست تسجيلًا دقيقًا وأمينًا لتضاريس طبيعة أو مدينة فقط. الكتابة كخريطة هي بحثٌ فيما هو أعمق، قد تسكُن الخريطة اللغة. أو قد تكون تسجيلا أمينًا لواقع ما ولكن إسقاطه يكون في الفانتازيا أو في الجحيم.
وفي نهاية القرن 16 حَسَب الفلكي جاليليو مساحة الجحيم في ملحمة دانتي الإلهية مُعتمِدًا على إشارة هذا الأخير لنصف قُطر الجحيم في قصيدته، ليجد أن مساحة جحيم دانتي هي نفسها مساحة فلورنسا، مدينة دانتي التي نُفِي منها.
*تنتمي هذه الشذرات لمشروع، قيد الكتابة، عن الأدب والجغرافيا في الجزائر.
————————–
عدي الزعبي: قدم العجوز الصينية
أحاول جاهدًا ان أضبط ملامح وجهي. أريد أن أشارك في الكلام، أن أتكلم أنا أيضًا عن الملل والفشل والزواج والعائلة والماضي والسويد والانتحار، ولكنني أصمت. لم أتكلم عن مشاكلي الشخصية مع أحد أربع سنين تقريبًا، منذ كارثة انتقالي إلى مملكة الدنمارك الفاشية، ثم هروبي منها إلى السويد…
قدم العجوز الصينية/ عدي الزعبي
“لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته، إذ من شرط المقلّد ألا يعرف أنه مقلّد، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده؛ وهو شعب لا يُرأب، وشعث لا يلمّ بالتلفيق وبالتأليف، إلا أن يُذاب بالنار ويستأنف لها صيغة أخرى مستجدّة”.
المنقذ من الضلال. حجّة الإسلام الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي.
(1)
يسأل المرء نفسه باستمرار عن علاقته مع التراث والتقاليد: ما الذي يعنيني في شعر كُتب قبل ألف عام، لا يشبهني ولا يعبر عني، بأطلاله ومدائحه وأهاجيه، وتكراره الممل، والتحرش بفتيات في مقتبل العمر من قبل كهول يلعنون الشيب في كل قصائدهم؟ ما الذي يربطني، اليوم، بكتاب مختلط غامض مربك سحري بلا معنى ولا مبنى مثل ألف ليلة وليلة، أو ممل وعظي مثل كليلة ودمنة، لا يفيد إلا في الاطلاع على الظروف الاجتماعية لمن كتبوا ولمن قرؤوا هذين العملين؟ ما الذي يعنيني من قراءات الفلاسفة للعرب لأفلاطون وأرسطو وأفلوطين: كل الفلسفة اليونانية، وسليلتها الفلسفة العربية ثم الغربية المدرسية، وصولًا إلى فلسفة النهضة الأوروبية، سقطت مع بدايات الثورة العلمية على أيدي جاليليو وديكارت: سقطت كليًا تقريبًا، بعلمها وميتافيزيقيتها ورؤيتها للعالم الحسي وغير الحسي. فقد افتتح رينيه ديكارت وفرنسيس بيكون العصور الحديثة بمقتلة كاملة وشاملة للتراث الإغريقي وكل ما نتج عنه، كأن العلم بدأ جديدًا.
كارل بوبر وتوماس كون، بعد قرون قليلة، قدّما مقولة مختلفة تمامًا: لا علوم بدون تقاليد. تولد الثورات العلمية من داخل تقاليد الماضي، بالضرورة. كل تقدم هو ابن الماضي، ابنه الشرعي. اختلف الرجلان حول كيفية فهم هذه المقولة، وخاضا معارك قاسية، حول طبيعة الحقيقة والعلم والتاريخ والنسبوية، معارك لم تنتهِ حتى بعد وفاتهما.
سلامة موسى طالب بالتجديد، وبالجديد. طه حسين وأدونيس رفضا قتل القديم: عملا، كل بطريقته، على نبش الماضي وجرّه، عنوة أحيانًا، إلى الحاضر. ولكن، يبدو ثقل الماضي أكبر مما نستطيع حمله: سقوط الامبراطورية الصينية رافقته حملة ثقافية تطالب بالتخلص من الكونفوشية، أكثر المذاهب تمسكًا بعبادة الأسلاف وتقديسهم، ومن البوذية المستسلمة ومن الطاوية السحرية؛ فيما كانت الحضارة الغربية، بجزع، تتطلع إلى المشرق، منذ إعادة اكتشاف حكمته تدريجيًا، مع توسع الاستعمار إلى كل بقاع الأرض، علَّها تجد بعض الراحة من دوامات حروب وعنف نفسي: من ديوان جوته الشرقي إلى تشاؤم شوبنهاور الحزين الحساس اليائس البوذي تقريبًا.
على أن التقاليد قد تبدو غير قادرة على ربطنا بالحاضر: هل نقرأ محاورات كونفوشيوس المملة جدًا وأشعار لي باي الجامحة، أم نقرأ مو يان ويو هوا ونشاهد زانج يومون لنفهم الصين المعاصرة؟ هل نقرأ سعدي الشيرازي أم صادق هدايت؟ هل يمثلنا نجيب محفوظ أم المتنبي؟
انتحر أكوتوجاوا، القاص الياباني المتفرد، يائسًا من محاولة المواءمة بين اليابان التقليدية والغرب (انتحر، بالطبع، لأسباب شخصية أخرى، كثيرة). انتحر بعده كاواباتا وميشيما، وكلاهما فشل في المواءمة. ما زالت اليابان واحدةً من أقسى المجتمعات الملتزمة بالتقاليد الاجتماعية: كيروساوا جسد هذا العذاب في فيلم ساحر غير مشهور بعنوان الأشرار ينامون بعمق، The Bad Sleep Well، عن الولاء للشركة: هذا المفهوم الفظيع، الذي تفاخر به الرأسمالية اليابانية بوقاحة منقطعة النظير. أما في فيلم ربيع مبكر، يعالج المخرج ياسوجيرو أوزو، على عادته، الموضوع ضمن دراما عائلية، عن زوج يخون زوجته مع زميلته في الشركة، في سياق كئيب محبط سوداوي.
يسأل المرء نفسه باستمرار عن علاقته مع التراث، مؤملًا أن يجد حلولًا أقل قسوة من الحلول اليابانية، أو الإسلاموية، التي جسدها سيد قطب: مواءمة قد لا تكون مطلوبة في النهاية: من قال إن العالم يمكن فهمه في مذهب متوائم؟
(2)
“أجل، لا أعرف ما الذي سأفعله. لا أريد الانفصال عن زوجي، وأحب هذا السويدي البارد البليد. لا لا، لا أحبه، ليس هذا حبًا. ولكنني أحب أن أقضي الوقت معه، أن أتسكع معه، أن أنام معه”.
تقول الفتاة، ثم تضحك.
كنت غارقًا تمامًا في ترجمة نص لباكونين، سيظهر قريبًا في كتاب يجمع بعض أعمال الفوضوي الروسي. في تلك اللحظة التي نسيت فيها سمّاعاتي على أذنيّ بدون موسيقى، كانت الشابة الآسيوية تتكلم بصوت خافت، مطمئنة إلى أنني غارق فيما أفعله.
بالطبع، لم أستطع أن أقاوم: تظاهرت بأنني أعمل، وأعطيت أذنيَّ الاثنتين، وقلبي وعقلي وجوارحي، لما ستقوله هذه الخائنة، الجميلة جدًا؛ متناسيًا نقد باكونين اللاذع، المُقنع حقيقة، لـجان جاك روسو، ولفكرة الإنسان البدائي الفرداني النبيل، والعقد الاجتماعي: يقول باكونين إن الإنسان وجد، منذ البداية، في جماعة: وبالتالي، إن فكرة الفرد النبيل البدائي وفكرة العقد الاجتماعي، سخيفتان تمامًا.
– “طالما زوجك لا يشك في شيء، استمري فيما تفعلينه. يعيش المرء مرة واحدة، يا أختي”.
أتت نصيحة السمراء، مع ابتسامة بريئة، متسامحة.
تتنهد سو، ثم تشعل سيجارة.
سو فتاة من آسيا، لها وجه مشرق صاف، وجسد متناسق؛ أقصد متناسق بالمواصفات الشرقية. على العكس من العرب والأمريكيين، لا تجد الصدور الكبيرة والشفاه الكبيرة والمؤخرات الكبيرة التي يزخر بها الشعر العربي القديم ودعايات التلفاز والفيديو كليب الأمريكي. تناسق هندسي، بسيط، كقصيدة هايكو.
شفتاها شهيتان، وعيناها الصغيرتان عميقتان، بسوادهما كبحر لا شواطئ له. رجلاها، المكشوفتان في الفستان الطويل بشقين على الجانبين، مرمر أبيض كثلج الشمال البارد. قدمها الصغيرة، التي تحررت من الحذاء الأسود الصغير بكعبه القصير، في جوربها ذي اللون اللحمي، لا ترتاح وهي تتحرك في كل الاتجاهات، كأنها راقصة شرقية تتحسس الفراغ على مهل وببطء، ثم تملؤه بدلع وثقة ورِقّة، كرقص سهير المرشدي في فيلم البوسطجي: في معمعة الخوف والتيه والقمع والنهايات التعيسة والبدايات الغامضة، مرحٌ جلّاب للمصائب، وللشبق والأمل والخطايا.
تقول سو إنها مرتبكة، إن الحياة لم تعاملها كما يجب، وإن أمها مسؤولة: مسؤولة عن كل هذا الخراب.
تهز السمراء رأسها. تتنهد هي أيضًا.
تقول السمراء إن صديقها خانها مرتين، ولكنها سامحته. في المرة الثانية، تكلما مطولًا، بدون دراما. قال إنه الملل. الملل دفعه للدخول في علاقة سريعة مع امرأة متزوجة عندها أربعة أطفال، الملل ليس منها، ولا من العلاقة الجنسية التي تبرد مع مرور الوقت، ولا من الحياة المشتركة: الملل بمعنىً أعمق، بمعنىً شامل.
تضحك السمراء، وتضيف أنه حيوان كاذب هائج كثور بري. كل قصة الملل كلام فارغ.
أحاول جاهدًا ان أضبط ملامح وجهي. أريد أن أشارك في الكلام، أن أتكلم أنا أيضًا عن الملل والفشل والزواج والعائلة والماضي والسويد والانتحار، ولكنني أصمت. لم أتكلم عن مشاكلي الشخصية مع أحد أربع سنين تقريبًا، منذ كارثة انتقالي إلى مملكة الدنمارك الفاشية، ثم هروبي منها إلى السويد.
تتابع سو الكلام، شارحة أنها تحب زوجها. التقيا في سيؤول، وتزوجا. سو في الخامسة والثلاثين من العمر، وهو في الثامنة والثلاثين. لم يمت الحب، ولكن شيئًا ما انكسر مع الوقت. كوريا تبتعد عنهما: تركا كوريا قبل سنوات طويلة، ولم يكتسبا صداقات في الغرب، ولا عائلة.
تقول السمراء إنها من عائلة فلسطينية، هاجر أهلها في بداية الثمانينيات من لبنان. تعلمت السويدية، وعندما كبرت، تركت عائلتها وراءها: رفض الأهل أن تحيا كما يحيا السويديون، رفضوا أن تنام مع أحد قبل الزواج. عندما انتقلت لتعيش مع ياكوب، جُن جنونهم. يعتقد أبوها أنها شرموطة. لفظت الكلمة بالعربية. التفت اثنان من رواد المقهى، ثم تابعا كلامهما تاركين السمراء تشكو. تقول إن أبوها يتمسك بهذه التقاليد السخيفة المتخلفة، وبتراث يجعله يرفض أن ترى أمها التي تعاني على فراش الموت.
أفتح على الحاسوب ملف الروايات، وفيه عشرات الروايات المسروقة من النت. كنت البارحة أقرأ رواية الحريق لـفالنتاين راسبوتين. كاتب روسي مميز. راسبوتين عنصري بوقاحة، يكره اليهود ويلوم الماسونيين على كل شيء، ويحتقر المثليين ويطالب بمحاكمتهم ويعتقد أن الغرب النذل جلبهم إلى روسيا لتخريبها؛ يحب فلاديمير بوتين، بالضبط مثل صديقه ومعلمه سولجنستين، الذي فضح مخازي معسكرات الاعتقال الستالينية. راسبوتين أيضًا مدافع عن البيئة، ولعب دورًا هائلًا واستثنائيًا في رفع الوعي في قضاياها، خصوصًا في سيبيريا. عايش الاتحاد السوفييت ثم سقوطه، وانهيار البلد في التسعينيات على يد المافيات، التي كان معظمها من أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم. راسبوتين متمسك بتراث القرية، ويكتب باسمها: يعتقد أنه يدافع عن التقاليد الروسية الأصيلة.
تضحك سو، تقول إنها لا تعرف بالضبط تراثها اليوم. المسيحية انتشرت ولكنها لم تتغلغل فعليًا. الإخوة في الشمال الكوري لا يشبهوننا في شيء. كوريا كانت دومًا بلدًا بين عملاقين مخيفين إمبرياليين: اليابان والصين؛ اليوم تتبع الولايات المتحدة الأمريكية ككلب أجرب. النجاح الاقتصادي عظيم ومريح، بالرغم من أنه تأسس فعليًا على يد ديكتاتوريات محلية وضيعة في بداياته.
أكاد أختنق. أقف فجأة، وأخرج من المقهى الصغير. أترك الحاسوب والحقيبة والمعطف خلفي، وأخرج وحيدًا.
حياتي مبعثرة، ومسيرتي المهنية متعثرة. لا أقصد داخليًا: أنا، كالرواقيين، حر تمامًا في حياتي الداخلية، ولا أحد يتحكم بما أفكر فيه وبما أكتبه. ولكن، كما تعرفون، الحياة الداخلية أكذوبة، أكذوبة بشعة منحطة اخترعها اليائسون كي يواسوا أنفسهم.
أمشي قليلًا بدون هدف.
سيارة تمر ببطء، أغنية “المدفعجية” تصدح:
“الفلوس تحضر
هاتلي من الأخضر
الفلوس تكتر
دلّعوني أكتر”
أردد، مع المدفعجية:
“دلّعوني أكتر”.
لا أحد يدلعني هنا، في المنفى. والفلوس لا تحضر. أعيش عالة على زوجتي. ليس عالة بشكل كلي؛ أحصل على بعض المال من الكتابة، ولكن أقل بكثير مما نحتاجه. يؤرقني الأمر كثيرًا. تقول زوجتي لأنني رجل شرقي تقليدي يؤرقني الأمر. تقول نحن شركاء، وأحيانًا أحصل على منحة أو جائزة كبيرة، تساوي ما تحصل هي عليه في أشهر.
لم أقتنع.
هل الزواج مؤسسة تقليدية؟ زوجتي تقول، أجل. ثم تشرح: ليست كل الأشكال التقليدية سيئة. السيئ والجيد ليسا مرتبطين بالتقليدي أو بالثوري، لا توجد علاقة مباشرة (هل عكس التقليدي ثوري؟ ألم تكن أغلب الثورات عودة للماضي؟ أليست ثورة النهضة الأوروبية مجرد عودة إلى ما مضى؟ كلمة “نهضة” باللغات الأوروبية “ريناسيناس”، تعني الولادة، مرة، أخرى، أي العودة للجذور اليونانية/الرومانية في هذا السياق).
زوجتي ذكية، ونسوية. ونحن نتشاجر دومًا. هي تتذمر باستمرار لأنني لا أستمع إلى ما تقوله.
أنت لا تستمع. أخبرتك عشرات المرات أنني لا أحب هذا الصابون الرخيص.
أنت لا تستمع. أخبرتك عشرات المرات عن باب الخزانة المكسور.
أنت لا تستمع. أخبرتك عن الطرد الذي يجب أن تستلمه غدًا من مكتب البريد.
أنت لا تستمع. أخبرتك أن أختي ستزورنا اليوم ويجب أن تعدّ العشاء.
أنت لا تستمع. أخبرتك عن موعدنا الساعة الثالثة في روضة ابننا.
أنت لا تستمع. أخبرتك ان تشتري مسحوق الغسيل والخبز.
على العموم، تعتقد زوجتي أنني أعاني من مشكلة جذرية في السمع.
أو هذا ما أعتقد أنها تعتقده. هي تقول إنني ذكوري، ومثل كل الرجال لا أسمع.
هذا أسمعه جيدًا، أسمعه كل يوم.
على أية حال، لا أعرف ما التقاليد التي تستند إليها في اتهامي بأنني ذكوري. كل صديقاتها يشاركنها الرأي في أزواجهن. أي أنني أتصرف ككل رجل أبيض ذكوري يعيش في الدول الإسكندنافية.
أقف متسمرًا في مكاني، في برد يقصّ المسمار، على ما يقول السوريون. معطفي وحاسوبي وما يحويه من أفكاري العميقة والضحلة في الداخل، ينتظرونني كي يكسبوا معنى. أنا، في الخارج، لا أنتظر شيئًا.
مطر خجول، كطفلة أول أيام المدرسة، يبلل الطرقات ويبلبلها.
يبلبلني الخجل، أنا أيضًا، لأعود إلى طاولتي بتعب.
أفتح الحاسوب، وأرد على رسالة من صديق قديم بعيد.
“عزيزي رائد،
سؤالك عن الواقعية وعن أثر القراءات المحلية فيما أكتبه صعب جدًا. يبدو لي، وبصدق حزين، أنني “مقطوع من شجرة”. بعد وفاة حنا مينة، وهو كاتب أحب رواياته المبكرة، كتب الروائي ممدوح عزام مقالًا يرثي فيه الرجل. مما قاله عزام، إن كل روائي سوري يبدو وكأنه يبدأ من نقطة الصفر، كأنه لا يوجد تراكم نقدي يتيح للكاتب أن يتابع مسيرة الآخرين. فيما يخصني، مقولة عزام صحيحة تمامًا. لست سعيدًا بذلك ولا فخورًا به، ولكنه واقع الحال.
لا أعرف السبب تمامًا. ربما لأنني أنفر من السائد في الكتابة العربية: من الواقعية الاشتراكية والفجة، ومن الديستوبيا والفانتازيا الجامحة البعيدة عن القلب، ومن استحضار التاريخ وتشويهه لأسباب سياسية، ومن تحويل الأدب إلى مشروع بروباجندا، سواء كانت اشتراكية أو تنويرية أو ثورية.
السؤال حول “الواقعية” معقد. مجموعتي الأخيرة كتاب الحكمة والسذاجة، واقعية تمامًا: التجريب فيها موجود أيضًا، ولكن في سياق الواقعية. تقليدية قليلًا: حكايا الناس، ولكن بتجريد كبير، لا يوجد وصف للمكان، ولا لأشكال الناس وأجسادهم وثيابهم. ربما يمكن وصفها بالواقعية شبه التجريدية. مصطلح الواقعية نفسه متعدد جدًا. ولا أرى أن هناك تعارضًا بين الواقعية والتجريب. هذا تعارض وهمي، رسمه اليساريون الذين أدانوا التجريب، والسورياليون الذين أدانوا الواقعية، في فترة محددة من تاريخ الأدب الأوروبي. كلا الطرفين كان يخوض معارك فكرية وسياسية متعددة على ساحة الأدب، فيها وضعية كونت وحماسة زولا له وتطرف لينين وتروتسكي ومحاولات بائسة ومملة لربط الفن بالحياة بطريقة غير مقنعة لشباب فرنسي تائه وغير ذلك من قضايا فكرية. اليوم، لا يوجد ما يدعونا لربط أنفسنا بسياق أوروبي محلي خاص، بل علينا تجاوز هذه الثنائية الساذجة. سأعود لاحقًا لشرح هذه النقطة.
أسأل نفسي، أحيانًا، في الأيام التي أعجز فيها عن الكتابة، لماذا ننتظر من الكاتب أن يتأثر بمن سبقوه محليًا؟ أعني، لماذا لا أجرؤ على القول صراحة، في مجال القصة القصيرة، إن إعجابي الشديد بالباكستاني سعادات حسن مانتو أو بالياباني أوسامو دازاي يفوق بأضعاف إعجابي بأي قاص سوري أو عربي؟ وإن أراد المرء أن يتناول فترات سابقة، يصبح السؤال أصعب: أعني هل أفضّل قصائد المدح السخيفة الطويلة جدًا التي دبّجها أبو تمام والبحتري على حساسية إميلي ديكنسون؟ الهجاء المتبادل المنحط بين جرير والفرزدق على الإنجليزي فيليب لاركين والصيني دو فو؟
يبدو لي أن كل سؤال التراث والتقاليد فارغ. أقصد أن الأمر فردي تمامًا: أنا أبجّل نجيب محفوظ ومحمد خان، بطريقة شبه دينية. لا أطالب الآخرين بنفس التبجيل، وإن كنت لا أفهم إطلاقًا أن يدعي أحدهم أنه لا يحب أعمال الرجلين. أعامل المعري وتلميذه طه حسين كأنني مريد درويش ساذج في حضرة أصحاب الطريقة. في المقابل، أفهم لماذا يقرأ البعض يوسف إدريس أو أنسي الحاج، ولكنني لا أحتمل قراءة سطرين مما كتباه.
ولكنني لم أتأثر، في قصصي ونصوصي الأدبية، بأيٍّ من أولئك الذين أبجّلهم من تراثنا. تعلمت منهم كيف أفكر، كيف أتصرف، كيف أحب، كيف أحزن، ولكن ليس كيف أكتب. ربما، ما تعلمته منهم أهم من الكتابة نفسها، أو ربما هو جوهر الكتابة بمعنى ما”.
تركت الرسالة هنا، غاضبًا من نفسي. ما هذا الكلام الغريب الذي أقوله؟ يعني، يبدو أنني لا أقول شيئًا ذا قيمة؟ ومن هو هذا الصديق الغامض، الذي يطالبني بشرح ما لا أستطيع، ولا يستطيع غيري، شرحه؟ ولماذا أكتب له عن الأشياء التي لا أجرؤ على كتابتها في مقال؟
كنت أتأمل سو شاردًا، وأنا أسأل نفسي تلك الأسئلة.
تلتفت سو إلي، وتبتسم ابتسامة ساحرة.
تسألني”هل أنت بخير؟”
أخي القارئ، أختي القارئة: لن يحصل هنا تغيير دراماتيكي، لن أشعر بأن وحدتي وهمية، وبأن الحياة جميلة فجأة لأن السيدة سو قررت أن تتكلم معي. يا ريت يا جماعة. مثل هذه التغييرات المفاجئة تحصل فقط في الأفلام الجماهيرية وروايات باولو كويلو ومع المتدينين الصادقين المحظوظين، كما في اهتداء القديس بولس أو خروج الإمام الغزالي من شكوكه. بقية البشر لا تتغير حياتهم أبدًا بنور مفاجئ يقذفه الغيب في الصدور.
ينتشلني السؤال من الأسئلة الأخرى. أدردش مع سو عن العمل الذي أقوم به. تقول إنها لا تقرأ إلا الأشياء المفيدة. لا تقرأ الفلسفة إطلاقًا. توافقها السمراء، التي يتضح أن اسمها فرح، وأنها سعيدة جدًا في حياتها، كما تقول بدون مقدمات لهذا التصريح الناري. فرح لا تقرأ إلا نادرًا. يسخران مني ومن ترجماتي للفوضوية، بخفة وظرافة محببة. أستعرض معلوماتي، بسخف وتباه، عن الكتب الأربعة التي قرأتها من الأدب الكوري. تقول سو إنها لم تقرا أيًا من هذه الكتب، باستثناء القليل من أشعار كو أون.
تثرثران سريعًا حول سوريا والحرب واللجوء وداعش، رفعًا للعتب. أهز برأسي، موافقًا على كل السخافات التي تتفوهان بها.
تسألني سو عن زوجتي وابني، عن أبي وأمي. تعاملني الفتاتان كأنني مريض فقير، ضحية، مثير للشفقة: ويعني هذا أنه يحق لهما أن تسألانني كل الأسئلة الشخصية الممكنة، لأنهما تريدان أن تظهرا كم تعطفان على اللاجئين.
أتمتم بأن الحياة صعبة، ولكن مقبولة الآن.
على طاولة مجاورة شيخ وحيد، يقرأ جريدة بصمت. وقار شيبه يجلل رأسه الملائكي، ويملأ الأرض كلها بسكينة دينية. لا أرى ملامحه بوضوح. أشعر بالطمأنينة لوجوده. ربما، لأنه يشبه الكاتب النجيري تشينو آتشيبي، ذلك الذي تنتهي رواياته دومًا بخسارات لا تُعوّض، ولكنها، بطريقة غامضة، تجعل القارئ يتشبث بالأمل.
انتقد آتشيبي بحدة رواية في قلب الظلام، واصفًا جوزيف كونراد بالعنصري. لا يظهِر أي شخصية إفريقية في الكتاب، حتى بعد أن يتحرر البطل من أوهامه: يبقى السود كائنات غير فعلية، موجودة فقط في الخلفية، كي يرسم كونراد لوحته المذهلة. آتشيبي، الذي درس في بريطانيا، كان يعرف أن الغرب شرير تمامًا، ولكنه، وبدقة مذهلة، كان يهاجم التقاليد البالية الهمجية المحلية في رواياته. في واحدة من أفضل قصصه فتيات الحرب، يروي قصة بسيطة عن الحرب الأهلية: فتاة جميلة تتحول من متطوعة متحمسة مليئة بالثقة والتفاؤل لمساعدة الثوار المطالبين بالاستقلال إلى نصف عاهرة. الحرب، تلك التي اتخذ فيها الرجل موقفًا حاسمًا إلى جانب الثوار، الذين انهزموا في النهاية بشكل كامل، بعد حصار طويل جاع فيه الناس وأكلوا القمامة وعشب الأرض، حصار طويل لم يهز ضمير أحد: الحرب هذه، والجوع، حولت معظم الناس إلى وحوش، إلى أوباش وعاهرات وقوادين، وعملاء لكل من يدفع لهم، على الطرفين.
تمسك يدي اليمنى بيدي اليسرى، بتوتر بالغ: كأن يدي اليمنى هي يد الشيخ النيجيري، أمسكها وأشد عليها بقسوة وغضب وغل: يتسامح معي العجوز الميت، ويبتسم بشفقة: ينقذني من سو وفرح.
تقول سو إن الحياة الزوجية مقدسة، إنها تعتقد أن الغربيين لا يحترمون حرمة الزواج. تهز السمراء رأسها موافقة. تشرح السمراء أنها تعتقد أن العائلة أهم ما في الإنسان. تقولان يجب أن نتمسك بالتقاليد، وتنتقدان الغرب: تنتقدان الوحدة وتحلل العائلة والبخل والفردانية وقلة التهذيب، والطعام المقرف، وماضي أوروبا الاستعماري، والعنصرية المنتشرة هنا. تحمدان الله أننا لسنا مثلهم.
أهز برأسي، لا أستطيع التعليق على ما تقولانه.
أكاد أبكي.
تفلتني يد آتشيبي: بعد حادث سيارة خطير، أصابه شلل نصفي. لم يعد قادرًا على مساعدة أحد.
أبقى وحدي، في مواجهة التقاليد، والغرب، وسو وفرح، والشمال البارد.
تقول سو إن علينا جميعًا أن نفكر بطريقة تقترب من البوذية: لا يمكننا مواجهة القدر، ولكن يمكننا أن نعالج أنفسنا، أن نفهم أن رغباتنا هي ما يتحكم بنا، وهي ما يجعلنا نعاني على الأرض. توافق فرح، وتقول إن كل ما يحدث مكتوب منذ الأزل عند الله. تقولان إنهما تحاولان أن تعيشا بسعادة، مهما كانت الظروف صعبة، وأنهما تتمنيان لي، ولجميع اللاجئين، حياة أفضل. فرح تطوعت لفترة في مساعدة القادمين من سوريا والعراق في أزمة اللاجئين 2015، وسو تقدم مساعدات شهرية بسيطة لإحدى منظمات مساعدة الأطفال الشهيرة. تعتذران وتقولان إن هذا كل ما يستطيعان فعله.
أتمنى لو أشرح لهما كم أكره التواكل والتسليم بالقضاء والقدر، وكل أنواع التصوف والبوذية وأحتقر التركيز على المشاكل الفردية الجوانية أكثر حتى من كراهيتي لخزعبلات ما بعد الحداثة. أنا “دقة” قديمة، يساري مؤمن بالمساواة بين كل الناس وبالعمل على تغيير العالم، ومتمسك بالتنوير الشكاك المنفتح، على طريقة هيوم وكانط. ولكنني أسكت. دائمًا أسكت.
هل لدى منفي فقير خائف مكتئب مهزوم فاشل بدين ساكت عن الحق، ما يقوله عن التنوير ومعنى الوجود وتحقيق الإنسان لذاته؟
تعتذران بصدق وود، في النهاية، عن كل شيء.
لم أفهم تمامًا ما الذي تقصدانه بقولهما “كل شيء”، ولكنني أحسست بصدق اعتذارهما الغريب العميق.
تغادران المكان.
أعود إلى طاولتي.
يقترب مني آتشيبي، ويضع يده على يدي، وينظر مباشرة في عيني.
أقول، بتردد:
“ما الذي سنحتفظ به من الماضي، في المنفى الطويل هنا؟ وما الذي يبقى بعد الحروب والهزائم؟ أليست التقاليد في صلب الحروب؟ وما الذي سنأخذه من تراث الآخرين الذي قدم لنا، وما زال يقدم، حروبًا وراء حروب وراء حروب؟”.
ثم، بتردد أكبر:
“وأنا لا أعرف أين أبحث الآن، أو، حتى، عن ماذا أبحث يا أستاذي”.
يجيبني، فيما النور يشع منه، كوليٍّ من أولياء الله:
“ليس لديَّ إجابات يا فتى. لا أحد لديه إجابات عن أسئلة كهذه. عليك أن تواجه كل ذلك، وحدك. الحروب لا تنتهي بعد وقف إطلاق النار، بعد الهزائم وبعد الانتصارات. عليك أن تواجه كل ذلك، وحدك. الحروب لا تنتهي. الأسئلة لا تنتهي، أيضًا. اسأل كثيرًا: ولا تبالِ إن لم تجد الأجوبة”.
ثم، بسماحة وثقة ومحبة، يضربني على رأسي بيده، ضربة الأب الحنون اللطيفة الخفيفة:
“مين رائد هاد يلي عمتكتبلو مراسيل يا عبقري زمانك؟ ارحمونا من الفانتازيا السخيفة”.
يتلاشى طيفه.
يبقى ظل ابتسامته السرمدية معلقًا في الهواء، كرائحة القرفة في مخبز حلويات سويدي.
(3)
لا نعرف بالضبط كيف بدأت عادة ربط الأقدام في الصين، أي عملية تشويه وكسر الأصابع الأربع الأصغر لأقدام البنات، وإجبار العظام على الانحناء، إلى درجة يقترب فيها الإصبع الأصغر من الكاحل، لتقليص حجم القدم.
استمرت هذه العادة لمدة ألف سنة.
العملية بسيطة: تقوم الأم بربط قدم بنتها عندما تبلغ سبع سنوات. تبكي الفتاة، وتقاوم، بحسب ما وصلنا من وثائق مكتوبة من نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. تضربها الأم بعصا غليظة، وتربط أيديها أحيانًا. تساهم الجدة أيضًا في العملية. لم تستطع النساء الزواج بأقدام طبيعية، بل ولم يتمتعن بمكانة اجتماعية مقبولة بدون الربط. الأم والجدة تقومان بما هو ضروري كي تُرضي الفتاة تقاليد مجتمعها.
كان ربط القدم شأنًا عرقيًا بشكل كامل. تعرضت الأقليات للاضطهاد وللسخرية لأن أقدام نسائهم طبيعية. بل حتى السلالة الملكية الأخيرة نفسها اضطرت للخضوع. حكمت أسرة كنج (1633-1912) الصين قبل قيام الجمهورية، وأصلهم من منشوريا، أي ينتمون إلى أقلية لها عادات وتقاليد مختلفة عن عموم الصين. لم يربطوا أقدامهم، كما لم تربط معظم الأقليات الأقدام. بل إن السلالة الغازية، ومنذ وصولها إلى الحكم، عارضت هذه العادة، بقوانين صريحة وغرامات مالية؛ ولكنها فشلت تمامًا في البدايات. انتهى الأمر إلى أن قلدت نساء منشوريا العادة بربط القدم من الأمام، كما فعلت الطبقة العليا الكورية تحت تأثير الثقافة الصينية، ولكن بدون كسر الأصابع. أعادت السلطة المحاولة في القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين. النجاح التدريجي كان جزءًا من عملية تحديث متكاملة، قادها فئات متعلمة من الشعب يحدوها رغبة جامحة بإصلاح البلد الذي كان يغرق بين أيدي المبشرين والقناصل الأوروبيين وامتيازاتهم والغزاة اليابانيين وفساد الإمبراطورية المخيف وجهل لا حدود له عند العامة.
من المؤكد أن العادة لم تبدأ إلا بعد انهيار حكم أسرة تانج (618-907). الحادثة الأولى التي سجلت تعود إلى راقصة في عهد السلالات المتصارعة الذي تلى الانهيار، ربطت قدميها ورقصت للملك. ثم بدأت نساء الطبقة العليا بربط أقدامهن. انتشار العادة ترافق مع أمرين: تغير الجو العام بخصوص مكانة المرأة في عهد أسرة سونج (960-1279) والعهود التالية؛ فقد تراجعت مكانتها بحدة عند السلطات والمفكرين مقارنة بالعهود الماضية؛ ووجود طبقة عليا أرستقراطية لا تحتاج نساؤهم إلى العمل: المرأة التي تربط قدميها تمشي، ولكن بصعوبة. بالتأكيد، لا تقوم بأعمال الزراعة ولا الأعمال المنزلية ولا بأي عمل آخر. العاملات في الأرض وفي الخدمات لم يربطن أقدامهن. أصبح الربط علامة مميزة للثروة والنبالة. لاحقًا، جادل الكثير من المفكرين بأن المرأة التي تعجز عن الركض ستعجز عن خيانة زوجها: المرأة العاجزة تمامًا مخلصة تمامًا. كان ذلك الزمن الذي انتشر فيه منع زواج النساء الأرامل أيضًا.
بالتدريج، بدأت الطبقة الوسطى، والوسطى الدنيا بتقليد الطبقات العليا، حتى أصبحت العادة منتشرة في الأرياف في عهد أسرة منج (1368-1644). ترافق ذلك مع هوس جنسي بالأقدام المربوطة، وبمداعبتها وبلحسها وبشرب الكحول من الأحذية الخاصة بها، كما انتشرت معلومات مغلوطة عن أن قفا المرأة وأعضاءها الجنسية تتغير لتصبح كل ممارسة كأنها ممارسة مع عذراء. الواقع أن عظام الأرجل والظهر تتعرض لتشويهات شنيعة، بالإضافة إلى آلام هائلة. كُتبت الأشعار والروايات بالأقدام الصغيرة، ودخلت العادة في الأساطير وفي الحياة اليومية وفي عادات الزواج وغيرها.
أصغر الأقدام، أي أجملها بحسب الصينيين في ذلك الزمن، تمتعت بها الطبقات الأغنى، والعاهرات: كن مشلولات تمامًا. أولئك النساء المحكومات كليًا بالعجز: أكثرهن تهميشًا ومعاناة، والأقل عملاً وحركةً. نساء بقية الطبقات، حتى عندما يربطن الأرجل، يتركنها أكبر قليلًا وقادرة على الحركة، لأسباب معيشية.
مع اجتياح المغول للإمبراطورية (أسرة يوان المغولية 1271-1368)، تحولت العادة إلى موضع فخر قومي لمواجهة الغزاة وحكامهم الذين احتقروا ربط الأقدام وسخروا منها بشدة. سيتكرر الأمر مع حملات التنويريين في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين: أصر المحافظون على العادة، واتهموا دعاة التغيير بأنهم عملاء للغرب وخونة.
استخدم الثوريون محاججات مختلفة، منها أن العادة حديثة نسبيًا، نشأت في القرن العاشر، وبالتالي ليست جزءًا من “التراث الحقيقي” للصين. كما أنها لا توجد إلا في الصين، وبالتالي ليست شرطًا للجمال أو للعفة بشكل عام لكل البشر، ويمكن تغييرها؛ كما أنها تمنع النساء من المشاركة في بناء الصين الحديثة. المثير جدًا، أن رفض العادة كان قديمًا، بل يعود إلى فترة نشوئها، ولم يتوقف يومًا. أكثر من ذلك، استخدم بعض الكونفوشيون الثوريون كونفوشيوس نفسه وأقواله لرفض العادة، كما استخدمه المحافظون من أجل تأكيدها.
لم تستطع الجمهورية منع العادة إلا بقوانين صارمة وغرامات مالية كبيرة وحملة دعاية هائلة بعد سقوط الإمبراطورية. حتى الستينيات، كانت العادة تُمارس بشكل خجول في أرياف الصين الشمالية، بالرغم من كل محاولات السلطات إيقافها.
لقرن من الزمن تقريبًا، واجه معارضو تشويه الأقدام التقاليد بشجاعة وصراحة وحزم، مؤمنين بمستقبل أفضل وأجمل وأرحب، قبل أن ينتصروا نصرًا ساحقًا ماحقًا.
كيف عاشت تلك النسوة كل ذلك؟
هنا ما تقوله حفيدة من قرية صينية نائية، سنة 2013، في لقاء صحفي، عن جدتها التقليدية، التي رُبطت أقدامها:
“جدتي تجاوزت التسعين وما زالت بصحة جيدة. عندها سبع دجاجات تعتني بهم. توفي زوجها عندما كانت في الأربعين. هي إيجابية ومتفائلة ومليئة بالحيوية والطاقة. عملت قابلة وجلبت أكثر من ألف طفل، عندما لم تكن المشافي موجودة هنا. كما عالجت بالأعشاب الطبيعية الناس عندما كانوا يعانون المرض والألم”.
ثم تضيف، بابتسامة فخر واعتزاز:
“جدتي ملهمتي الحقيقية في هذ العالم”.
—————————-
=======================




