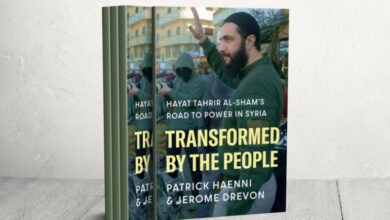الرواية التي لم يكتبها بورخيس… عن اللاوعي الفاشي واليقين بالأنا/ عمار المأمون
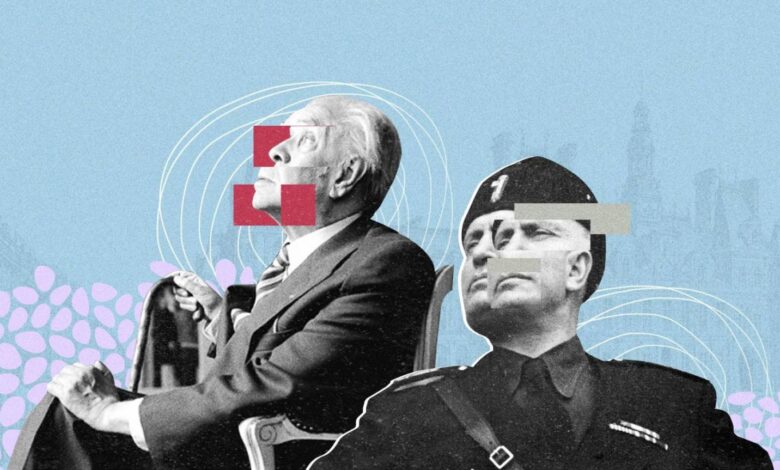
“إلى بينيتو موسوليني، مع تحيات رجل عجوز يجد في شخص القائد بطلاً للثقافة”، فيينا، 26 أبريل، 1933. الإهداء الذي كتبه سيغموند فرويد على الصفحة الداخليّة لكتابه “لماذا الحرب؟”، والذي وصل إلى يد موسوليني عبر صديق إيطالي.
رواية بورخيس
عام 1921، عاد خورخي ل. بورخيس من أوروبا إلى الأرجنتين. الشاعر الشاب تلمس حينها صعود الأفكار الفاشية في بلاده، فكتب لصديقه كارلوس مينسيس، أنه يطمح لإنجاز رواية فانتازية يكتبها مع عدد من الأصدقاء. لخص بورخيس حبكة هذه الرواية، بأنها تدور حول خطة بلشفية سريّة للسيطرة على الأرجنتين، عبر نشر “عصاب عام” بين الناس.
لم يكتب بورخيس هذه الرواية، لكن لاحقاً، وبعد ظهور الفاشية بشكل واضح في الأرجنتين، اتُهم بورخيس بأنه يهودي وأنه متآمر ضد الأمة، لكن ما يمكن فهمه من هذه الرواية المفترضة، أن بورخيس تنبأ -كعادته- بداء جماعي ينسف الحقيقة، ويستبدلها بهلوسة جماعية، قائمة على الإيمان لا التفكير العقلاني في الواقع.
نقتبس الحكاية السابقة من كتاب “تاريخ موجز للأكاذيب الفاشية”، الصادر مؤخراً للمؤرخ الأرجنتيني فيدريكو فينشلستاين، الذي يناقش الكذب، لا فقط كأداة سياسية، بل أيضاً كحقيقة داخلية، يؤمن بها حتى من ابتدعها، كجوزيف غوبلز، مفوض الرايخ للحرب الشاملة، الذي نشر خبر كاذباً عن نجاته من محاولة اغتيال، بل وأصرّ على الكذبة في مذكراته التي لم تكتب للنشر.
هذا التصميم نابع من رأي غوبلز بأن البروباغندا “ليست فنّ الكذب أو تشويش الحقيقة، بل الإصغاء إلى روح الناس”، وهذا ما يحاول الكتاب رصده في العلاقة بين “الحقيقة” و”الكذب”، إذ يشير إلى أن الفاشية، على المستوى الفردي، نابعة من “إيمان بحقيقة كبرى”، تمثل انعكاساً لرغبات داخلية تسكن الأفراد. لا يهم تصديق أو نفي هذه الحقيقة، بل الإيمان بتعاليها، وبـالـ”قائد” الذي يتقمّصها، لا فقط يمثلها، كونه تجسيداً مادياً لرغبات الشعب التي يمارسها القائد بجسده، انفعالاته وقراراته.
الأنا” و”الإيمان” و”اللاوعي”
يتكرر الحديث عن “الإيمان” في الكتاب، وهو ذاته ما كان يحاول بورخيس رصده في روايته غير المكتوبة، التي كان من المفترض أن تناقش “هوساً” جماعياً بفكرة تبدو عصابية، لكنها شديدة المنطقية للمؤمنين بها. لكن الاختلاف عن الدين يظهر بأن هذا الإيمان ليس فقط روحياً، بل حداثيّ يسعى لتغيير الواقع بالعنف والتضحية والعلم، وينفي التجريبي على حساب الحدس والعاطفة، اللذين ينبعان من دواخل الأفراد “المؤمنين”، ويتجسدان في كلمات الفوهرر، الدوتشي أو القائد الخالد، المشابه للبطل الرومانسي، ذي العبقرية الفردية والروح الثورية النقية.
وهذا ما نقرأه في وصف بثينة شعبان لحافظ الأسد بعد اتصال مع بيل كلينتون، إذ تقول في كتابها “عشرة أعوام مع حافظ الأسد 1990-2000”: “أيقن المواطن السوري أن الرئيس حافظ الأسد يعرف ما هو الأفضل لمصلحة الشعب السوري، ووثق به من أعماق قلبه فيما يتعلق بالشؤون الخارجية”.
هذا “اليقين” الذي مصدره قائله فقط، هو ما سنركّز عليه في قراءة الكتاب، إذ لن نخوض في سياسات ما بعد الحقيقة، وكيفية نسف الواقع على حساب الأسطورة، بل سنركز على مفاهيم “الأنا” و”الإيمان” و”اللاوعي” التي تُوظف في الأنظمة الفاشية، والتي يشير الكتاب أنها تمتد من الشرق الأوسط حتى أمريكا الجنوبية، هذه الأنظمة مقتبسة من الأحزاب الوطنية اللاتاريخية في بداية القرن العشرين.
و كلمة “لاتاريخية” هنا تعني أن المؤمنين بهذه الأفكار يرون ظهورهم أشبه بلحظة قطيعة، تنفي الماضي وتغيّر الحاضر وتتنبأ بالمستقبل عبر “الطاعة والجهاد”، الشعار الذي رفعته جماعة القمصان الزرقاء في مصر، بداية القرن العشرين.
ترى الأفكار الفاشية نفسها تعبيراً عن اللاوعي -ليس بالمعنى الفرويدي المنحطّ والدنس والكرنفالي- بوصفه الرغبة والإرادة التي تتجلى علناً، فهو مصدر الحقيقة الذاتية التي تترجم عبر السياسة على أرض الواقع، وهنا يظهر هذا الإيمان كـ”يقين” بأن الأنا هي من تمتلك الحقيقة وتصدّرها، في رهان على عقلانية فهم اللاوعي مهما كان غامضاً متناقضاً.
فهو ليس مساحة للعب والرغبات المكبوتة كما في أعمال فرويد، بل مخزن للحقيقة المتسامية، أما الانتقال، حسب فينشلستاين، من الرغبة اللاواعية إلى الوعي، فيتحقق بالعنف والقوّة اللتين تغيران الواقع، ليتناسب مع الحقيقة الداخلية المتسامية بوصفها أبدية، تتكشف في “السيد” ورغباته، بوصفه “تقمصاً” للرغبة الجمعية للـ”مؤمنين” به.
هذا الإيمان لا يتطلب تمثيلاً سياساً، ولا حدود قانونية لـ”إرادة” السيد، الذي يتصرف باسم الأفراد ويحقق رغباتـهـ(ـم) التي تمثل حقائق متعالية تنبع من يقين الأفراد الذاتي، النابع ليس فقط من حسّهم بالفرادة والتفوق، بل من عبقرية السيد نفسه، الذي يدرك أن الواقع مليء بالأعداء، ولابد من تصفيتهم، وهنا يمكن أن نتخيل المؤامرة التي افترضها بورخيس.
العصاب الجماعي نابع من ذوات مجتمعة، اشتد إيمانها حتى تجسّد سيداً ينفي تناقضات العالم الخارجي، موظفاً العنف في سبيل تحقيق “واقع” غير واقعي، كلما ازداد الإيمان الفردي به ازدادت “الحقيقة” وضوحاً وعقلانية وبساطة، بل ويمكن اختزالها بعبارات تردد بسهولة: إن كان المشكلة في اليهود، لنحرقهم كلهم، Voila!، الحلّ بسيط وقابل للتحقيق، لأن الأفراد يؤمنون بأنه “رغبتهم”، وهذه الرغبة لا تتحقق إلا بالقوة.
الحقيقة بمعناها الأيديولوجي
نعود للحقيقة بمعناها الأيديولوجي، ما هي؟ حسب فينشلستاين، الفاشيون يرونها كـ”أسطورة متعالية، جذورها في اللاوعي الجمعي، يتم تحقيقها عبر وبواسطة وعي القائد وجسده وكلامه”. هذا التعريف يقترح أن “الأنا” لا ترى في اللاوعي مساحة خطرة أو غير مفهومة، بل مكاناً منطقياً لرغبات “صادقة” نابعة من عمق الذات بمعناها الروحي، تلك التي تمارس هذا الإيمان في طقوس الطاعة والحياة اليومية.
الأهم، هذه الرغبات التي تريد تغيير الواقع، بعكس إيمان بورخيس، لا تعترف بسلطة الكلمات ولا قدرتها على التغيير أو التمثيل، إذ يرى الوعي الفاشي أن الكلمات عاجزة حتى عن تمثيل الأحاسيس وما يدور بالنفس، تلك التي تظهر رغباتها عبر الحدس الداخلي الذي يترجم منطقياً بالعنف، فالأفعال هي ما تعمل في الواقع، لا الكلمات القاصرة.
رومانسية الفاشي
يظهر الفاشي هنا رومانسي، كونه “يفضل قوة الحدس على التفكير”، رغبته هي ما تقوده ولو كان هذا يعني فناءه، كـأدولف إنكمان، الضابط النازي، الذي وصفت حنا أردنت كلماته الأخيرة بالكليشيه، إذ قال “تحيا ألمانيا، تحيا الأرجنتين، تحيا النمسا، لن أنساهم أبداً”. لكن لنفكر بهذه الكلمات، ماذا يعني لن أنساهم؟ هل يقصد البلاد؟ أم أقرانه الذين صمتوا، وبقيت “رغباتهم” دفينة؟
يبدو إنكمان وكأنه يقدم التحية الأخيرة إلى تلك الرغبة المحبوسة في “لاوعي” رفاقه في السلاح، تحية إلى الحلم الذي قد يتحقق طالما هناك إيمان، خصوصاً أن موت القائد لا يعني فناء الحقيقة التي جسدها، كونه يحيا في لحم المؤمنين به، ينادونه وكأنه ماثل أمامهم يحييهم.
نتلمس هذه الرومانسية الفاشية في رواية بورخيس المتخيّلة والتي لم تكتب، فبعد إحباط المؤامرة البلشفية، أُلقي القبض على العلماء المسؤولين عن تطوير الغاز الذي سبب العصاب الجماعي، ووقفوا أمام فرقة الإعدام، سبعة علماء تم إعدامهم رمياً بالرصاص. فرقة قناصة خاصة أطلقت 7 طلقات استقرت في جباههم، لكن، لاحظ مصوّر الإعدام لاحقاً، أنه في أجزاء الثانية الأخيرة من الإعدام، إي قبل أن ترتطم الرصاصات بجباه السبعة، كانوا يبتسمون.
يفسر بورخيس ذلك لاحقاً في الرواية، بأن الزمن توقف لسبع سنوات في تلك اللحظات، واستعاد السبعة كل تواريخهم الشخصية أمام أعينهم، إذ تحرر لا وعيهم، ورأوا رغباتهم مرئية أمامهم، وتذكروا القائد وكيف أطلعوه على الخطة، وكيف صافح كل واحد منهم بشدّة، واصفاً إياهم بـ”يده التي تحقق رغبات الأمة” فابتسموا، ولحظتها، أكملت الرصاصات طريقها واخترقت جباههم السبع.
حرب الفاشية على فرويد سببها بأنه وصف الرغبة الجمعية بوجود بطل أو مخلص برواسب من اللاوعي الشهواني والرغبة بالفناء، والحرب ليست إلا الشكل “الحداثي” لمحاولة عقلنة هذه الرغبة التي تقود نهاية إلى الموت، موت القائد، وموت من حوله، ثم فناء الجميع.
تلك الرغبة الدفينة في النفس البشرية، والتي إن تقمصها القائد فعلاً، شَبِق الجميع بها، لكن المثير للاهتمام أن هذه الرغبة التي تسكن اللاوعي وتحركه، يستطيع القائد فقط تفسيرها وفهمها، كحالة موسوليني، الذي لم يجد في الدولة تمثيلاً مجرداً للشعب، بل تعبيراً عن “رغبة” هذا الشعب. فهي كائن حيّ وحيوي لا تحده النُظم القضائية، ولا يمكن الوقوف بوجه انفعالاته، أي هي لا تمثل السيادة الشعبية، بل تتقمص لاوعي الشعب ورغباته التي قد يعجز غير المؤمنين عن فهمها.
هذه الرغبة الذاتية لدى المؤمنين تنفي أدوات التحليل النفسي، كونها لا تعترف بوجود ما هو غامض، غير مفهوم أو حيواني في اللاوعي. هناك ادعاء بإدراك كامل للأنا، التي قد تخطئ بإدراك الواقع أو فهمه، لكنها لا تخطئ في فهم النفس وما يدور فيها، فالواقع مضطرب وغير واضح، يشوّهه الأعداء، بعكس الذات النقية التي تؤمن بتقمصات القائد ورغباته.
رصيف 22