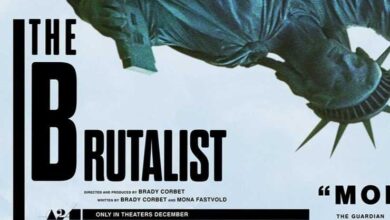فيلم ” نوماد لاند” Nomadland (2020)

لاتقل وداعاً في نوماد لاند/ كوليت بهنا
لم تستثن جائحة كورونا حفل توزيع جوائز الأوسكار المفترض أن يقام يوم غدٍ في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، وكغيره من عشرات النشاطات والفعّاليات الحيّوية العالمية الهامة، فرضت شروطها القسرية عليه وأجّلته حتى نهاية شهر أبريل القادم.
رغم ذلك، نجحت معظم الأفلام المنافسة من الوصول إلى العالم الذي تمتع بمشاهدتها عبر الشاشات المنزلية قبل وقت كاف. أضف أن بعضها حظي بحظٍ طيب وشارك في مهرجانات سينمائية دولية تمكنت من عقد دوراتها في موعدها، مستغلة بعض فرص تراجع الفيروس النسبي عن بعض مناطق العالم في الأشهر الفائتة.
Nomadland- المعرَّب تحت اسم أرض الرحّالة، لمخرجته وكاتبة السيناريو الصينية الأميركية كلويه تشاو، والمقتبس عن رواية للأميركية جيسيكا برودار، واحد من أهم هذه الأفلام التي طافت العالم والمنافس بقوة على أبرز جوائز الأوسكار في دورته 93 لهذا العام، حاصداً في جولته العالمية جائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي، والأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية 2020.
المتابع لهذا الفيلم، قد يطرح بداية بعض التساؤلات حول هويته، أو حول مدى توافقه مع الذائقة الجماهيرية مع غياب العديد من مواصفات الفيلم الأميركي التقليدية عنه، التي تحرص في المعتاد على إبراز هيبة انتاجها الضخم أو مؤثراتها البصرية أو مبالغاتها الخارقة للقصص والنجوم.
سرعان ماسيبدد الفيلم هذه التساؤلات ويقدم إجاباته بنفسه، فارضاً برقّة هيبته الخاصة وأسلوبيته المغايرة بوصفه فيلماً أميركياً خالصاً، ينطلق بقوة من بيئته إلى رحاب الهوية الإنسانية العالمية الجامعة، والتي نسجته بأنفاس صبورة ليبدو قطعة فنية تتلائم مع مصير الفرد الأميركي ومصائر الأفراد حول العالم، أولئك الذين دفعوا جميعاً ثمن العولمة وأمسوا ضحايا الأزمة المالية الكبيرة التي عصفت بالاقتصاد الأميركي أواخر سنة 2008 وتركت تداعياتها الحادة والخانقة على جميع اقتصاديات العالم.
لا جماليات مصطنعة في نوماد لاند، إذ تهيمن الطبيعة الحرّة على فضاء الفيلم كلاعب رئيسي يستحضر مكوناته الأصيلة من أراض جرداء شاسعة وصخور وصحارى وطرقات طويلة معبدة أو وعرة، وسط تقلبات مناخية تتأرجح وسط تأثيراتها اللطيفة أو القاسية، مصائر أبطال الفيلم من أصحاب المقطورات المتحركة الذين باتوا يعيشون مايشبه حياة الغجر أو حياة البدو الرحّل.
هؤلاء الذين باتوا يشكلون فئة اجتماعية جديدة مهمشة مضافة، ممن فقدوا بمعظمهم حق السكن المستقر والآمن خلال مواجهاتهم الخاسرة مع الرهانات العقارية الشرسة وديون البنوك، وألفوا أنفسهم مشردين يطوفون الأرض في عربات “الفان” التي تحولت إلى بيوتهم الحميمة الجديدة، وبرفقتها، سيخوضون تحديات تحول حيواتهم ويعيدون اكتشاف بيئات متنوعة لموطنهم وذواتهم وهوياتهم، واكتشافاتهم الثرية لمعاني التحرر الشامل من الطغيان المادي وتشييء الإنسان وحياته.
باستثناء فرانسيس ماكدورماند، بطلة الفيلم الرئيسة الحاصلة على عشرات الجوائز العالمية الرفيعة من بينها أوسكارين كأفضل ممثلة، سيبدو نوماد لاند فيلماً بلا نجوم يتمتعون بالوسامة والشهرة، لكنهم جميعاً ودون استثناء، سيلعبون أدوارهم بأداء ساحر في صدقه، وتكاد وهلة لاتميز إن كانوا يمثلون باحترافية مدهشة، أم هم أناس عاديون جيء بهم ليلقوا بأثقالهم ويبوحوا بمكنوناتهم أمام كاميرا عابرة في فيلم تسجيلي.
في نوماد لاند، ستمسك المخرجة كلويه تشاو مع بطلتها فرانسيس بزمام الأمور بقيادة نسوية ملفتة، رغم أن الفيلم لايطرح نفسه بصفته نسوي من حيث القضية أو الرسالة، أو بسبب جنس مخرجته وبطلته ووجود عدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في متنه، لكنه رغم ذلك يمكن النظر إليه من عمق هذا المنظور النسوي الذي منح روح الفيلم تلك اللمسة العذبة من الدفء الخاص، والتي تسربت في ثناياه ونجحت في المقاربة بين روح الأرض والأنوثة بشفافية، ولغة شعرية قاربت الشكسبيريات التي استُحضرت كإجابات ملهمة على بعض أسئلته الوجودية.
سيبقى نوماد لاند طويلاً في الذاكرة، ومع كل أزمة اقتصادية جديدة تفرز ملايين الحيوات المشردة في إثرها، سيتجدد طرح الأسئلة حول الذات والمصير، ومدى أهمية تحرر الانسان من فخ التشييء قبل رحلة التيه، ومعنى الخلاص الوجودي الذي يكمن في التواصل البشري وتبادل المحبة، في حياة قصيرة نهايتها الرحيل.
الحرة
——————————
فيلم «أرض الرَحالة»… رثاء للإنسان والمكان/ سليمان الحقيوي
تستمر المخرجة الصينية كْلُوي شَاو (1982) في التنقيب عن قصص تطبعها العلاقات العميقة، فقد تناولت العلاقات العائلية في فيلمها «الأغاني التي لقنها لي إخوتي» (2015)، وقدمت في فيلمها «الراكب» (2017)، محكيا فريدا عن استمرار حياة البدو في العالم الحديث، عن تشبت رعاة البقر وراكبي الأحصنة بثقافتهم، الآن تجد موضوعا آخر ـ رغم كونه مقتبسا عن كتاب جيسيكا برودر- إلا أنه يبدو من صميم عالم المخرجة، المنحاز إلى من تعاكسهم الحياة، جميعها قصص قد لا تستهوي مخرجين آخرين، مثلما قد لا تناسب الجمهور الباحث عن التقلبات المفاجئة للقصص الحركية، أعمالها تبني علاقات مع الشخصيات والامكنة ببطء وترو بالغ الحذر، لذلك فأفلامها ذات الميزانيات المحدودة، دائما ما تترك أثرا كبيرا في المناسبات الداعمة للسينما المستقلة، بدون تقدير كبير لدى الجمهور، لكن فيلمها الجديد «أرض الرحالة» (2020) ينجح في لفت الانتباه إلى سينما بجماليات كبيرة تضاهي القصص العظيمة التي تقدمها.
«فيرن»
نتعرف في الفيلم على «فيرن» في دور آخر عظيم لفرانسيس مكدورماند، تجد نفسها مثل كثيرين في نهاية عمر لم يعرفوا فيه سوى العمل في شركة الجبس الأمريكية في مصنع إمباير نيفادا التي أعلنت في 31 يناير/كانون الثاني 2011، الإغلاق الشامل، بسبب انخفاض الطلب على الألواح الصخرية، وكان القرار يعني عمليا إنهاء وظائف الجميع في المعمل، ودفعهم إلى مغادرة المنازل التي كانت الشركة تؤجرها لهم لقاء أثمنة منخفضة 250 دولار شهريا. المدينة كانت تابعة للشركة ومرتبطة بها، لذلك بعد اغلاقها، تم إغلاق مكتب بريد المدينة وشطب الرمز البريدي «89405» نهائيا من السجل الوطني.
رغم كوننا أمام دراما واقعية واضحة البناء والمعالم، دراما مخلصة لخصائص هذا النوع، إلا أن الفيلم يحرك الكثير من المياه الراكدة في الثقافة الأمريكية تحديدا، الفيلم من ناحية ما، هو صخرة تتكسر عليها الكثير من شعارات الجنة الأمريكية، لا حلم أمريكي هنا، في الفيلم هناك كابوس لمسنين يواجهون انتكاسة كبيرة لصناديق تأمين التقاعد، لذلك هم مضطرون للعمل في سن كبيرة، وفي الغالب هذا العمل لا يسد حاجياتهم اليومية، خصوصا السكن. يستند الفيلم إلى كتاب يحمل الاسم نفسه للصحيفة جيسيكا برودر، الذي تتبع فيه قصص عدد من كبار السن من الأمريكيين (معظمهم بين الخمسينيات والستينيات) ممن يواجهون أزمة كبيرة في تأمين تقاعدهم، وينتهي بهم الأمر ليصبحوا عمالًا ويفضلون العيش في عربة سكن متنقلة أو خيام. تصبح فيرن واحدة من هؤلاء، بعد أن فقدت زوجها، ووظيفتها في مصنع الجبس.
مقارنة بين الشخصيات
تحيلنا الفضاءات المفتوحة إلى عقد مقارنة سريعة بين الشخصيات هنا، وشخصيات أفلام الغرب الأمريكي، فالفيلم يسير، عكس بنية الحكي في أفلام الغرب حيث يمشي البطل مزهوا بانتصاراته بدون ندم أو اهتمام بترك أثر في الأمكنة التي يمرّ بها، هنا الجميع منكسر الجميع مهزوم ـ رغم أن البقاء في الطبيعة ـ خيار طوعي لكثيرين، الجميع يريد البقاء، لكن الظروف تدفعهم إلى طرف الحافة. الحقيقة الوحيدة الفاضحة لتغول قوة رأس المال هي: ألا ملاذ للإنسان إلا نفسه، هي بمعنى آخر ـ يقول لنا الفيلم ـ حقيقة نصلها في نهاية العمر، لكن الأفضل أننا وصلنا إليها.
تختار المخرجة أن يكون المشهد الأول مواجهة بيننا وبين البطلة فيرن، هذه المواجهة عبر عين الكاميرا الموجودة داخل المرآب، في وضعية عكسية تماماً للمألوف، الكاميرا هكذا تعزز فكرة الاستقرار، العلاقة المستمرة مع المكان، الألفة حتى، لكنها على خلاف ذلك كانت ترسم في الفيلم آخر لحظات العلاقة بين فيرن وهذا المكان، الذي كان يمثل كل شيء بالنسبة لها. تنجح هذه اللحظة في إبراز قيمة المكان، وربط مغادرته بالخسارة الفادحة. وهنا لا تنشغل الكاميرا بالعودة إلى هذا الباب من أجل تعزيز فكرة غلقه أو تركه مفتوحا، المهم أن فتح الباب هو فتح لجراح الشخصية التي نشك أن تندمل من جديد، وهي تقنية سنشاهدها في الفيلم لاحقا، خصوصا في مشهد زيارة فيرن لمنزلها في آخر الفيلم، الكاميرا عندما يتعلق الأمر بالأماكن المغلقة، تستمر في ترقب الداخلين إليها متربصة بدخول الشخصيات وليس العكس.
فلسفة الفيلم المنحازة
فلسفة الفيلم المنحازة، كما يبدو، إلى التقشف بدءاً بالميزانية المحدودة جداً، تناسب الكثير في القصة عن فئة تبحث عن الحد الأدنى من أجل الحياة، في مشاهد كثيرة تصر المخرجة على إبراز هذه الفلسفة، تَبادل الحاجيات الزائدة عن اللزوم بين شخصيات الفيلم، التخلص من كل ما هو فائض.. المجد ليس للمادة هنا على الإطلاق، المجد لدفء العلاقات الاجتماعية. تجد هذه المعاني طريقها إلى النفس عبر موسيقى لودوفيكو أينودي المركزة على تكرار نغمات البيانو نفسها التي تسير في التطور والقوة، العازف الإيطالي العظيم هو أحد ممثلي البساطة (الحد الأدنى) في الموسيقى الأوروبية، موسيقاه عرفت كيف تعبر عن مشاهد التيه الذي تعيشه بطلة الفيلم تحديدا، عرفت أيضا كيف تتبعها في لحظات الضعف، الفرح والانكسار.
في أرض الرحالة تجد شاو عملا يلائم أسلوبها الذي ظهر في فيلميها السابقين، مشاهد ممتدة وطويلة تذوب فيها الحدود بين الوثائقي والروائي، اقتفاء الكاميرا للشخصيات وفتح مجال الصوت بين الإطار وخارجه، ومواجهة الكاميرا للشخصيات، كما لو أنها تحصل شهاداتهم، والاعتماد على طاقم كله من الممثلين الهواة، باستثناء فرنسيس ماكدورماند وديفيد ستراثيرن. إنه أسلوب يغني القصة ويترك للفيلم فرصته لإيجاد صوت يميزه ويكسر التقيد بكتاب جيسكا برودر فلا تركيز هنا على الإضاءات الكثيرة للكتاب التي تنهج الإشارة إلى المسؤول عن الأزمة، والمتسبب فيها، الخطة هنا تبدأ من تجنب ذكر الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى فوضى تصيب كبار السن، ويختار الفيلم أن يقتفي قصة إنسانية واحدة تركز على شخصية واحدة تنضم إلى الباقين، تجد فيهم تعويضا عن خسارات العمر، هو تعويض صغير، لكنه مناسب لنهاية العمر، الجميع يبدو راضيا بحياته الجديدة، مقتنعا بأن الحل يكمن في عودة الإنسان إلى الأصل إلى التضامن، عندما ستقابل أحدهم سيجيبك بسعادة كما فعلت فيرن في مشهد من مشاهد الفيلم، «أنا لست بلا مأوى» أنا فقط «بلا مأوى» وهناك فرق..
سينمائي مغربي
القدس العربي
—————————
“نومادلاند”.. أرض ميعاد مزيّفة/ محمد صبحي
في خطابها الوجيز عقب فوز فيلمها “نومادلاند”(*) بجائزة “غلولدن غلوب لأفضل فيلم”، الإثنين الماضي، قالت السينمائية الأميركية الصينية، كلوي تشاو (1982)، إن “الفيلم في جوهره هو رحلة حج من خلال الحزن والشفاء.. لكلّ من مرَّ بهذه الرحلة الصعبة والجميلة في مرحلة ما من حياته، هذا الفيلم لكم”. هذه الكلمات الرقيقة تلخّص كثيراً حال الفيلم، وما يمكن استخلاصه منه، وحتى طريقة التعاطي معه.
في ثالث أفلامها الروائية الطويلة، تواصل كلوي تشاو حديثها عن الأساطير الأميركية، الغربي منها تحديداً. في فيلمها الأول، “أغانٍ علّمني إياها أخي” (2015) تعاملت مع الحالة البائسة المعاصرة للهنود الأميركيين، وفي ثاني أفلامها، “الراكب” (2017)، انغمست في حياة رعاة البقر ومسابقات الروديو، مختارة ان يكون بطل الفيلم راعي بقر لم يعد بمقدوره امتطاء حصانه، وفي “نومادلاند” تذهب البطولة لامرأة (فرانسيس مكدورماند) فقدت كلّ ما حدّد حياتها في السابق، لتعيش في شاحنتها، بعيداً من مظاهر الحضارة الحديثة، وتنغمس في البرية والطبيعة، من دون أن تستطيع الفهم ما إذا كان هذا الاختيار قد أُملي عليها بذريعة الرغبة في العزلة أم كنتيجة للظروف الاقتصادية وانهيار السوق الأميركي في أعقاب الأزمة العالمية في 2008. وبذلك، تنظم الأفلام الثلاثة، بطريقة ما، ثلاثية فيلمية غير رسمية حول الأساطير المؤسِسة للولايات المتحدة وتفكّكها الحتمي، وراهن انحلالها الجلي، وإن كان ذلك يأتي في محاولة – يائسة أحياناً – لإبقاء تلك الأساطير على قيد الحياة من جانب أبطالها المختارين، الذين، مثل المخرجة، رغم كل شيء، يؤمنون بفكرة أميركية تماماً حول وعد الحرية وعيش المرء لحياته كما يريد.
لا تفتقر تشاو إلى المنطقية، وهي أيضاً قادرة على إيجاد قصة مثيرة للاهتمام وموقع أحداث لافت في كل مرة. ما يعوزها فعلاً هو متعاونين موثوقين، وأولاً وقبل كل شيء كاتب سيناريو ومونتير (قامت بمونتاج وكتابة سيناريو الفيلم بنفسها)، يمكن أن تتواصل معهم وتهيّئ قصصها بشكل أفضل، بدلاً من الانتهاء بها إلى التيه في ذهابٍ وإياب ملتبس، بلا بوصلة حقيقية. من هذا المنظور، يمتلك “نومادلاند” فصلاً أخيراً مُمّلاً وخاملاً من فرط تكراره وضياعه في المشهديات الطبيعية الشاسعة، بما يمثّل إهداراً غير مفهوم لما استثمره في بدايته المثالية عن عالم “سكان المقطورات” ومنبوذي الحلم الأميركي. التحوّل إلى تصوير الفضاءات والأشجار والفراشات وثور البيسون، يبدو أكثر ملاءمة لقناة “ديسكفري”، حيث لا مكان لبقية الفيلم بالطبع. حتى يبدو الفيلم في نهايته، كعمل شبه وثائقي عن الأميركيين البيض العاطلين عن العمل، الذين تعلّق المخرجة حول أعناقهم إكليلاً من وعود الحرية واليوتوبيا المزيّفة في تصريحاتها العامة، تماشياً مع أيديولوجية الحلم الأميركي.
هكذا، تعود أسطورة الروّاد المستكشفين الأوائل – كما تقول أخت البطلة، في مرحلة متأخرة من الفيلم – مثلما تعود الاستعارات الكلاسيكية عن حياة الرُحَّل الأميركيين المعاصرين، ممن يعيشون في بيوتٍ متنقلة وحياتهم على/وفي الطريق دائماً وأبداً. البداوة والترحال المفروضان على بعض الأميركيين، كما يخبرنا الفيلم في بدايته، أملَتهما تداعيات الأزمة الاقتصادية، كما حدث في وقت الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وانتهى الأمر بأفراد وعائلات مُشرَّدة تعيش في بيوت/مقطورات بعدما أسقطهم “السيستم” من حساباته. لكن، بدلاً من التفكير في هذا الموضوع، حيث كان يمكن على سبيل المثال أن تتّخذ نموذجاً مثلما في ملحمة سينمائية من طراز “عناقيد الغضب” (1940) لجون فورد عن رواية لجون شتاينبك، تلجأ تشاو إلى الحياة الداخلية لبطلتها، وتخبرنا أنه في الواقع، إذا أرادت، كان بإمكانها الحصول على منزل ثابت، لكنها لا تجد في داخلها رغبة بذلك، بسبب مشاعر وروابط فقدتها ولن تعود أبداً. تعيش على الذكرى، وتدفع شبح الموت بخوض التجارب والتخفّف من الأحمال، على طريقة الرهبان الفرنسيسكان.
وفي “نومادلاند”، نفقد أيضاً الوجود المادي/الجسدي الذي كان الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في فيلمها السابق. فمع الحفاظ على كتابة تتنقل بين الوثائقي والروائي، وهي سمة تميّز كل أفلام المخرجة، لدرجة أن الممثلة فرانسيس مكدورماند تتناغم جيداً مع الممثلين المساعدين (وأغلبهم رُحَّل حقيقيون يعيشون في عرباتهم)؛ تكسر تشاو التوازن هذه المرة، بعد افتتاحية ممتازة، لصالح روايتها الخاصة لموضوعها المأخوذ في الأصل عن كتاب لجيسيكا برودر من العام 2017 بعنوان “نومادلاند: البقاء على قيد الحياة في أميركا في القرن الـ21″، ووضع خطابات “مُدخَّنة” في أفواه الشخصيات، تصبح أقل تصديقاً مع تقدُّم الفيلم. مثلاً، في أحد المشاهد المزعجة، ثمة مُعلّم أبيض عجوز بلحية بيضاء يتحدث عن “استبداد الدولار”، وسطوة السوق، ثم يقول “إن تيتانيك تغرق بالفعل”، ويريد توفير “أكبر عدد ممكن من قوارب النجاة”.
وبإهمال الطبيعة الجسدية، يغوص الفيلم تائهاً في بحر رمال رمزي: ديناصورات (مستنسخة في ساحة صحراوية، ثم يتكرر ذكرها مرات عديدة)، أفعى ضخمة، تمساح مهيب، مناظر طبيعية لامتناهية للأراضي الوعرة، أشجار أقدم عُمراً من الولايات المتحدة، بحر هائج وصخور، وأحجار أزلية نرى العالم من فجواتها؛ كل شيء يتراكم ويتكرر كما في بطاقات بريدية لا تتحول أبداً إلى تسلسلات/متواليات يمكن التشييد عليها، يتبع بعضها بعضاً بلا استمرارية سردية – ولكن رمزية فقط – لتقول أشياء عن الخلود والطبيعة الشاسعة، من ناحية، وأشياء عن الشيخوخة وضآلة الإنسان من ناحية أخرى.
والنتيجة؟ خطاب إنساني على صورة جميلة داخل قصة ضعيفة، بلا حبكة، بلا دراما، “آرتي بوفيرا” لا يطوّر فَنّ الفيلم بل يأخذه إلى الوراء. والمؤسف أن يأتي ذلك من سينمائية واعدة حقّقت، من قبل، إحدى التحف السينمائية الصغيرة في القرن الجديد، لتتبعه بفيلم أشبه ما يكون بماء الورد، يتدفق بعيداً من دون ترك أي أثر، في حين أن ممكنات محتملة لصناعة فيلم أجمل وأفضل كانت حاضرة على الدوام في تفاصيل قصة البطلة، والصعوبات الحقيقية التي كان من الممكن أن تواجهها لم تؤخذ في الاعتبار أبداً. لم تنجح كلوي تشاو في تحقيق قفزة نوعية، على الأقل إخراجياً، وبدلاً من ذلك حققت قفزة كبيرة على المستوى الدولي، بالتتويج بجوائز مهمة. في المقابل، وقعت تشاو في الفخّ المألوف لسينماها حتى الآن: كتابة هشّة وصعوبة تشريح موضوعها، مع انسياق مزعج لـ”شَعْرنة” صورها على طريقة تيرانس ماليك.
إذا كان فيلم “الراكب” مثيراً للإعجاب، فهذا أيضاً لأننا كنا نخشى على حياة البطل. هنا، على الرغم من أنها تعيش بطريقة محفوفة بالمخاطر، إلا أن البطلة لا تبدو أبداً في خطر. لذلك يبدو “نومادلاند” فرصة عظيمة ضائعة، فكرة رائعة ألقيت بعيداً، حيث حتى إمكانية التصوير في مستودع “أمازون”، عملاق الشحن والتجارة، لم تحرّك ساكناً في داخل المخرجة، المنسحبة باهتمامها إلى دواخل بطلتها أكتر من اهتمامها بتثمير الإمكانات التي تحت يدها.
(*) فاز الفيلم مؤخراً بجائزة غلودن غلوب لأفضل فيلم وأفضل إخراج. في أيلول سبتمبر الماضي، بدأ مسار التتويج، بفوزه بجائزة الأسد الذهب في “مهرجان البندقية السينمائي”، لتصبح أول مخرجة تفوز بهذه الجائزة منذ حصول صوفيا كوبولا عليها في العام 2010. كما فاز الفيلم بجائزة اختيار الجمهور في “مهرجان تورونتو السينمائي”. الآن، تبدو حظوظه وفيرة للتتويج الكبير في ختام موسم الجوائز بجائزة أوسكار التي لم يعلن بعد عن ترشيحاتها الرسمية.
المدن
————————–
«نومادلاند» منافس قوي في موسم جوائز السينما
في التمثيل والسيناريو والإخراج
هوليوود: محمد رُضا
على مدى الأشهر الممتدة من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اليوم، نال «نومادلاند» لمخرجته كلوي زاو 132 جائزة لا مجال بالطبع لتشكيل قائمة كاملة بها هنا، لكنها بدأت بجائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (في ذلك الشهر) واستمر منوالها أسبوعاً وراء أسبوع. في العديد من الحالات نال هذا الفيلم أكثر من جائزة في مناسبة واحدة، مما يفسر العدد المرتفع من الجوائز وما زال مرشّحاً لـ94 جائزة آخرها ما صدر من ترشيحات «غولدن غلوبز» في الأسبوع الماضي.
آخر الجوائز الفعلية أعلنت في حفل افتراضي يوم الأحد الماضي عندما خرج «نومادلاند» بجوائز عدة من «حلقة نقاد لندن». ترشيحات ناقد «الشرق الأوسط» ذهبت إليه في أكثر من خانة بينها خانة أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس. الخانة الأولى لهذه القدرة البديعة للمخرجة في دمج أسلوبي الرواية والتسجيل من دون اللجوء إلى ما يُعرف بـ«دوكيودراما»، كما سنتعرّف بعد قليل. والخانة الثانية هي لطريقة كتابتها ما صوّرته لاحقاً بدراية لا تقل إبداعاً.
بعد الفقدان
كلوي زاو هي أيضاً منتجة الفيلم (مع آخرين) والتي قامت بتوليفه (مونتاجه) أيضاً بذلك حافظت على رؤيتها ومعالجتها من اللقطة الأولى إلى الأخيرة. وهي اقتبست الفيلم من كتاب غير روائي وضعته الصحافية جسيكا برودر سنة 2017 وروت فيه رحلة امرأة في حاضر داكن لحياة قطاع من الأميركيين فقدوا الحلم الكبير ويعرفون ذلك. هذا، عملياً، في مقابل قطاع، ربما أكبر، فقدوا الحلم ذاته لكنهم ما زالوا يجهلون ذلك.
يتابع الفيلم رحلة امرأة متوسطة العمر فقدت الزوج وفقدت العمل وقررت أن تجوب الولايات المجاورة للولاية التي تنتمي إليها (نيفادا). لم تكن رحلتها سياحية ولا من باب التعويض عن سنوات من العمل في بلدتها الصغيرة ولا حتى للقاء ابنة أو ابن لها يعيشان في بلدة أخرى. كانت، بكل بساطة، رحلة للعيش خارج المنظومة الاجتماعية الكبيرة.
في البداية فكر المنتج بيتر سبيرز، كما قال لهذا الناقد، أن زاو سوف تقوم بعملية اقتباس شاملة تسند فيها للممثلة فرنسيس مكدورمند دور الصحافية برودر:
«هذا كان الخاطر الأول لي ولشركائي عندما قرأت السيناريو الذي بعث به لي وكيل أعمال الممثلة فرنسيس مكدورمند. لكن عندما تعرّفت على زاو وتحدّثنا في العمل تبدّى لي أن المخرجة تنوي الخروج من مجرد نقل ما هو مسرد في الكتاب لتصوير حالة أبعد بكثير».
سرعان ما انضمت فرنسيس مكدورمند إلى العمل كمنتجة لجانب زاو وكلاهما كانا على اتفاق نموذجي منذ البداية. يضيف سبيرز: «لا تنس أن زاو سبق لها أن أخرجت فيلمين أسندت فيهما أدواراً رئيسية لغير محترفين كما الحال هنا».
الحال هنا أن هناك ممثلين معروفين فقط هما مكدورمند في دور المرأة الراحلة فيرن، والممثل ديفيد ستراثرن. الباقون من غير المحترفين وبينهم ليندا ماي وأنجيلا رايز وباتريشا غرير وكارل هيوز. لكن حتى مكدورمند وستراثرن لعبا دوريهما بإنزال الأداء لما دون مستوى الاحتراف لأنه لا يمكن لكليهما (خصوصاً لمكدورمند التي تظهر في كل مشهد من الفيلم بينما دور ستراثرن يحتل نحو خمسة مشاهد فقط) أن تنفصل عن باقي المؤدين بخبرتها وحرفتها إلا على حساب تلك المعالجة التي قامت بها المخرجة.
تضع كلوي زاو خلفية بطلتها خلفها فعلاً. الفيلم لا يبدأ بتوفير مشاهد لإغلاق المصنع الذي كانت تعمل فيرن (مكدورمند) فيه. ولا يهمّها أن تباشر الوضع بحوار بين فيرن وأي شخص آخر لإيضاح ما حدث. كل شيء ينطلق بقرار فيرن ترك البلدة.
الأمر ذاته بالنسبة لزواجها الذي انتهى باكراً. هناك ذكر له لاحقاً لكن لا مشاهد تلج بنا إلى الحاضر أو مشاهد استرجاعية لتبيانه.
البيت ليس منزلاً
ما يبدأ الفيلم به هو الحالة في ساعة مبكرة من يوم ما: لا زوج ولا عمل. تترك بيتها منتقلة إلى حافلة صغيرة (Van) وتقودها في الدروب الصحراوية البعيدة. الحافلة ستشغل البال قليلاً لأنها ليست جديدة ولاحقاً ما سيتطلب الأمر تصليحاً لها، لكن فيرن تصحح أحدهم عندما يفترض أنها بلا بيت (Home) ترد عليها «عندي بيت لكن لا أملك منزلاً»(House) والفارق شاسع لغوياً كما في مفهوم فيرن التي لا تعتبر نفسها شبيهة بالذين يعيشون على الترحال لذاته، بل هي في مرحلة من حياتها قررت لها أن تجول في تلك البُنى المهمّشة من أميركا الكبيرة. تجمع بين رغبة الاطلاع ورغبة العيش ورغبة أن تكون امرأة مستقلّة في المقام الأول.
كل من حولها (باستثناء ستراثرن الذي يؤدي شخصية «جار» في حافلة أخرى منضمّة إلى «مخيم» الحافلات) شخصيات تؤدي حياتها وواقعها من دون تمثيل بمن في ذلك برادي الآتي من مستوطنة للأميركيين الأصليين («الهنود الحمر») يعرف تماماً أن الحياة أمامه كالتي وراءه شبيهة بتلك الأراضي القاحلة حوله. ربما هو أول من توقف عن الحلم الكبير بين من نقابلهم.
هناك شخصية مواطن أصلي آخر في فيلم أميركي حديث هو «دعه يمضي»(Let Him Go) والشخصيتان مشتركتان في إنهما لم يعدا يجدان في أميركا لا الماضي الذي ينتميان إليه، حسب العِرق، ولا المستقبل تبعاً لوعود الحياة والسياسيين. كلا الفيلمان أيضاً رحلة صوب وجه آخر لأميركا. في «دعه يمضي» (أخرجه توماس بيزوكا( عائلة من زوجين يتركان راحة بيتهما إلى حيث يقابلان عائلة أخرى تختلف في كل مبدأ ونحو أخلاقي. هذا الاكتشاف للوجه الآخر هو أفضل وأمضى وضعاً هنا لكن العملين يتحاذيان على هذا النسق وفي الموضوع لا أكثر.
تميّز «نومادلاند» عن أي فيلم آخر هو تميّز نابع من الصلب. ناقدة مجلة «سكرين دايلي»، فيونيولا هاليغن، أصابت الهدف تماماً عندما تعجبت، حال مشاهدتها الفيلم في مهرجان فينيسيا، حول كيف يمكن لفيلم صغير كهذا «توفير مرآة للمجتمع وتلوي الضوء لكي تعكس حياة المشاهدين أيضاً». لكن بالإضافة إلى ذلك هناك مسألة أن هذا الانعكاس لم يكن ممكناً على نحو بالغ التفاعل نفسياً ومجتمعياً لو أن المخرجة سردت الفيلم كحكاية. ليس فقط لأن هناك حكايات عديدة سبق تقديمها حول «الأميركانا» وانعكاساتها، بل أساساً لأن الحكايات الأخرى تقدّم نفسها كنماذج للواقع بينما يتشبّث هذا الفيلم بالواقع.
كنسيم بارد
نجد فيرن تنتقل من مخيّم لآخر وتعود أحياناً لما تركته تحت مظلة بيئة مشتركة قوامها أناس طيّبون هم مثلها استجابوا لمثل هذه الهجرة وذلك الترحال. لكن معظم هؤلاء هم ضحايا الوعد الذي لم يتحقق والأمل الذي لم ينجل. أما فيرن فلا تعتبر نفسها ضحية حتى وإن كانت بالفعل كذلك. هي ضحية انقلبت على كونها ضحية وأضحت المرأة التي ترفض أن تندثر تحت ثقل الوضع وتختار أن تعيش فوقه ولو بارتفاع بسيط. حين تعود إلى منزلها الخاوي (توم هانكس يعود أيضاً لمنزله الخاوي في «نيوز أوڤ ذا وورلد» الحديث أيضاً) تقرر، وقد أزف الفيلم على نهايته، إنها لم تعد تريده مسكناً. لا يعني لها أي شيء، تماماً كما لا يعني لها الاستقرار في المكان الواحد الذي ربطها ذات يوم بعائلة وعمل.
الحياة التي عاشت عليها اندثرت. انتهت. اختفت. حياتها الجديدة لن تؤدي إلى ما هو أفضل من السابقة لكنها ستضمن لها استقلالها عبر الترحال.
أداء مكدورمند، الذي سيضمن لها ترشيحاً قوياً للأوسكار، تماشى، كما تقدّم، مع متطلبات المعالجة التي اختارتها المخرجة. وهي إذ منحت الكتاب غير الروائي حياة روائية التزمت بالواقع من دون أن تدّعي أنها تقدّم فيلماً واقعياً على أي غرار. ذلك المزج دقيق وشعري ويمر على الشاشة كنسيم بارد مع قليل من الموسيقى والكثير من تصوير جوشوا جيمس رتشردس الذي تعامل مع المناظر الطبيعية بإضاءتها الخاصة داخل وخارج الأماكن. من قاد سيارته من نيفادا إلى أريزونا ومن أريزونا إلى كاليفورنيا سيجد الكثير من مآرب لسيارات – منازل تؤلف بعيداً عن قارعة الطريق بيئات لأمثال فيرن والنماذج التي التقت بها. تنأى بنفسها عنك وأنت تجوب براحة سيارتك ومذياعها وبرّادها الهوائي. لكن أنظر جيداً وتمعّن كيف أن بعض الأميركيين يفضّلون قطع أواصر الحضارة والحاضر للعيش في كنف البادية. إذا لم يمر طريق سفرك بهذه البيئات شاهد «نومادلاند» وسيعطيك المعنى ذاته وأكثر.
لمشاهدة الفيلم اتبع الرابط التالي