يا أهل الشام .. أفيقوا أنا جوعان/ محمود الوهب
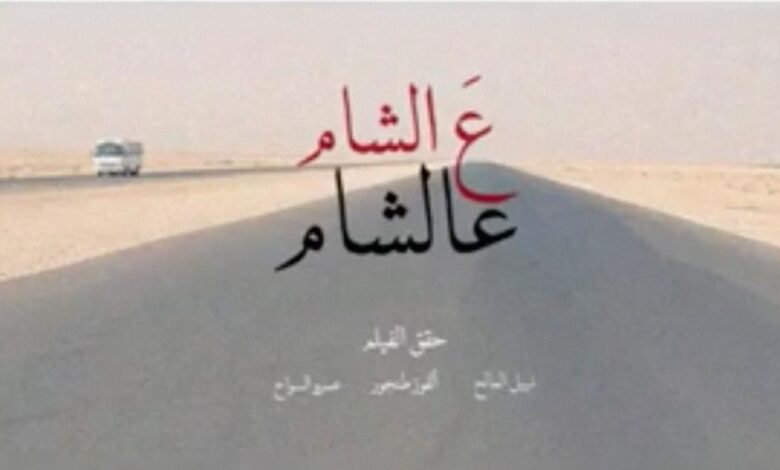
إذا كان النظام في سورية، منذ اليوم الأول لأحداث درعا، قد قال بالمؤامرة، واختار الحل الأمني، وأخذ يوجِد المبرّرات لمواجهة الشعب، فإن الحقيقة كانت غير ذلك، لا بكلمة الحرية التي صدحت بها حناجر الشباب متنوعي الانتماءات والتوجهات والمواهب، بل بما قاله مثقفو سورية، منذ سطا حافظ الأسد على السلطة عام 1970، مستعرضين حقائقها، كل في مجال نشاطه فكراً أو أدباً أو فناً. وكثيرة الأسماء التي عبّرت عن حال البلد، إذ لا يزال إنتاج هؤلاء يُتداول حاملاً نبض أرواح، وفيض محبة، فما دوِّن وأحسن صياغته قد مزّق غطاء الزيف عن الواقع الذي كان، واقع الوطن والمواطن. فما صِيغ قبل الثورة كان تنبيهاً إلى أخطارٍ قد تحصل ردّاً على نتائج سياسات خاطئة تغطّيها شعاراتٌ تحوّلت إلى رهاب المجتمع، وتبرير الفساد، وإبراز صورة الحاكم، وتجاهل أوجاع الشعب من فقر وتهميش، ما يؤكد أن الثورة السورية جاءت في سياقها التاريخي، وكانت انفجاراً بركانياً. وبغض النظر عما آلت إليه، وأخطاءٍ بعضها أتى ردة فعل على ما ارتكبه النظام من قتل وخراب وتهجير واستقواء بالأجنبي، وبعضها الآخر نتيجة القمع الشامل.
توفي، في 3 فبراير/ شباط عام 2011 المخرج السينمائي عمر أمير لاي، وفي 24 منه عام 2016 توفي نبيل المالح. ومع أنَّ السينما عاشت بؤساً زمن حافظ الأسد، واستمرّت في عهد خَلَفَه، لكن المخرجيْن قدما أفلاماً تسجيلية/ وثائقية عكست حقيقة الحال السورية، فقد أخرج أمير لاي عام 2003 الجزء الثالث من ثلاثية أفلامه عن سد الفرات، “طوفان في بلاد البعث”، ورصد مشاهد ذات دلالات، ورموزاً كشفت أستار النظام، وبراقعه الكرتونية. فما كان يعانيه الواقع السوري من أوجاع، وما قد يقود إليه من أخطار، أكبر مما يتصوّره المرء. يبدأ الفيلم بعرض قدمٍ لفلاح تشقّقت من تعبٍ ومعاركةٍ للأرض، لينقل المشهد إلى تشقّق الأرض ذاتها من عطش، وليقف بعدئذ ذياب الماشي، شيخ عشيرة الماشي، وهو العضو المزمن في مجلس الشعب، ليعطي المشاهِدَ صورة واقعية عن المجلس، إذ يبدأ بكيل المديح لحافظ الأسد، لا لسبب وطني أو قومي، بل لنيله عطايا “الأب القائد”، ولمساهمة عشيرته في فكّ إضراب مدينة منبج أوائل الثمانينيات. تنتقل الكاميرا إلى المدرسة التي يُفترض أن تكون أساس كلِّ بناء في عصرنا الحديث، ليفاجأ المشاهد بأن جوهر التعليم وغايته إنما تكمن في ترديد شعار “البعث” وإعلاء صور القائد وتربية منظمات طلائع “البعث” وشبيبة الثورة واتحاد الطلبة. أما حين يخطئ الطالب في قراءة معلومة أو كتابتها أو عرضها فلا تثريب على المعلم إن لم يتدخّل! (يذكر أن موجها تربويا تقدَّم لفحص العضوية العاملة في حزب البعث، ولم يوفق في إجابته، فقال مبرّراً: يا رفيق، أتريدنا أن نكون فلاسفة؟ نحن نحْضُر الاجتماعات، ونردّد الشعار..) أما الحواسيب التي جاءت عطاءً من الرئيس الوريث، بحسب مدير المدرسة الذي عرَّف نفسه بأنه “ابن أخ دياب الماشي”، فهي في صناديقها تنتظر من يعرف أصول تشغيلها. وتجول الكاميرا في صفوف المدرسة وباحتها وتلاميذها ومعلميها، مؤكّدة فراغ العملية التربوية المتماهية مع دولة حافظ الأسد وابنه.
لم يبتعد نبيل المالح (1936 – 2016) كثيراً في فيلمه “ع. الشام” الذي صوّره في 2006، معتمداً على مقابلات الناس في قراهم ومدنهم، ما أوحى بإرهاصاتٍ تنذر بأخطار مستقبلية، ففي وقتٍ كان فيه بشار الأسد يغلق منتدياتٍ وصحفاً كان قد سمح بها، ويضع بعض الذين تحسّسوا أوجاع المجتمع وبينوا أسبابها، في السجن، كانت كاميرا المالح تجول في معظم المدن السورية وقراها، لترصد حال السوريين، وتشير إلى أية هوّة يذهب البلد. وهكذا من تدمر إلى دير الزور فالحسكة والقامشلي، ومن أرياف إدلب وحمص وحماة وحلب واللاذقية إلى درعا والسويداء تتالى أوجاع الناس في صور بؤسهم التي تكشف عملية فراغ القرى من أهلها، والذهاب إلى دمشق أو بيروت، بحثاً عن العمل وسد حاجة العيش، إن لم يكن تأمين مستقبل لمن هم في سن الشباب، فكثير من بيوت القرى تناقصت إلى درجة زوال بعضها كلياً، بينما تكتظّ المدن الكبرى بنازحي الفقر والعوز، ولا وظائف عند الدولة، فقد تسلط على مكتب العمل بعض المرتشين، فأوصلوا تسعيرة الوظيفة التي تؤمّن راتباً شهرياً قدره ثلاثة آلاف ليرة إلى 150 ألف ليرة (أكثر من ثلاثة آلاف دولار). وحتى إذا أراد أحدهم أن يحصل على قرض، فإنه مضطر إلى دفع رشوة، وشبابٌ كثيرون يدفعهم العوز إلى التسرّب من مدارسهم، بحثاً عن ضرورات العيش لأهلهم، فتموت أحلامهم وتذبل براعم إبداعهم قبل تفتحها. أما دمشق، ذات الوجه الجميل في مخيلة هؤلاء الشباب، فتغدو مصدر كراهية وأحقاد، نتيجة ما يعانونه في أعمالهم من ظلم وقسوة، وتمرّ الكاميرا عليهم تحت جسر الرئيس وفي سوق الهال، حيث أعمال الخدمات وجرّ العربات كما الحمير. ولا تختلف حال الفتيات عن حال الشباب، فالفقر يؤجل الزواج، ولا يؤمّن سكناً مريحاً ونظيفاً ولا حياة هانئة لأطفالهن، فالكل يطحن الحزن والأحلام بعيدة المنال.
في العودة إلى دمشق (الدولة)، تتالى الأسئلة البديهية لماذا؟ ومن المسؤول؟ وما الخلفية؟ وكيف يكون لنا كل ذلك الذهب بألوانه الأربعة الأصفر (القمح) والأخضر (الزيتون) والأبيض (القطن) والأسود (البترول)، ويبقى الشعب في حال من الفقر والقهر؟ ذلك ما لم يستطع المالح هضمه. ففي كل كلمة قيلت أمام الكاميرا، وعلى كل وجه قابلها حكايا للقهر، وصور للبؤس، وكبت يكاد يزلزل الأرض. وقد كثفها المالح بصوتٍ يأتي من بعيد. يأتي عميقاً، حزيناً، ينادي “يا أهل الشااااام أفيقوووا .. فأنا جوعااااان” يأتي معبّراً عن مدى بعد الحاكم عن المحكوم، ومنبّهاً، في الوقت نفسه، إلى أخطار قادمة، إنها نبوءة الفن في حال صدقه، وقد صدق.
العربي الجديد




