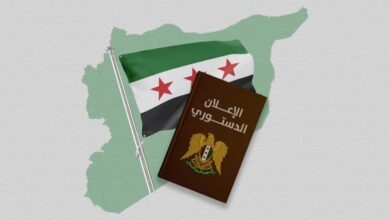وداعا ” ميشيل كيلو” 1940-2021 ، بمثابة رسالة وداع من “صفحات سورية” أكثر من ألف مقال في الموقع وعشرات الحوارات يقدمها الموقع

تلفزيون سوريا يجري اللقاء الأخير مع ميشيل كيلو قبل دخوله العناية المشددة
تسجيل صوتي لميشيل كيلو يتحدث عن رايه في الحدث السورية
تسجيل صوتي آخر اـ “ميشيل كيلو”
وفاة ميشيل كيلو… نصف قرن في محاربة الاستبداد
“لن يحرّركم أي هدف غير الحرّية فتمسّكوا بها، في كلّ كبيرة وصغيرة، ولا تتخلّوا عنها أبداً، لأن فيها وحدها مصرع الاستبداد”. هذه كانت كلمات من رسالة مطولة، ودّع فيها ميشيل كيلو السوريين قبل أكثر من أسبوع، على وفاته في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 81 عاماً. ودعا كيلو السوريين، في رسالته التي عُدّت بمثابة “وصية سياسية”، إلى “نبذ العقليات الضدّية والثأرية”، والاتحاد على كلمة سواء ورؤية وطنية جامعة “كي تصبحوا شعباً واحداً”، في محاولة منه قبيل وفاته لتبديد سُحب يأس لم تفارق سماء السوريين في الداخل والخارج.
توفي كيلو فيما يعيش السوريون تحت وطأة أزمات معيشية في الداخل، والتشرد بكل ألوانه في الخارج، وفيما باتت سورية عرضة للتقسيم، بعدما تحوّلت إلى مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية. رحل كيلو منفيّاً، قبل أن يقطف بنفسه ثمار نصف قرن من العمل السياسي المعارض لتقويض نظام الاستبداد في سورية، ولكنه شهد على مدى أكثر من عشر سنوات انتفاضة السوريين التي لطالما حلم بها، وقضى من أجل الوصول إليها سنوات طويلة من عمره في معتقلات نظام الأسد الأب والابن.
لم يتفق السوريون على شخصية منخرطة في العمل السياسي المعارض منذ أكثر من 50 عاماً، مثلما اتفقوا على ميشيل كيلو، المولود في مدينة اللاذقية على الساحل السوري عام 1940، والذي درس الصحافة في مصر وألمانيا، وعمل عام 1966 في دائرة الترجمة بوزارة الثقافة في دمشق. انخرط كيلو في العمل السياسي المعارض منذ سبعينيات القرن الماضي، حين كان حافظ الأسد يهندس نظاماً استبدادياً يقوم على أسس طائفية وتحكمه أجهزة أمنية وأدت الحياة السياسية في البلاد.
ناصب كيلو نظام الأسد الأب العداء منذ البداية، وعرّى في مداخلة له أمام “اتحاد الكتّاب العرب” عام 1979 ما يسمّى بـ”الجبهة الوطنية التقدمية” التي كان شكّلها الأسد من أحزاب تدور في فلك حزبه، “البعث”، في خطوة من ضمن خطوات اتخذها لفرض الهيمنة السياسية الكاملة على البلاد وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تيارات يمكن أن تشكل خطراً على نظامه.
في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، اعتقل نظام حافظ الأسد، ميشيل كيلو، بسبب معارضته محاكمة أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في سورية، والتي نشطت في معارضة نظام الأسد الذي فتك في عام 1982 بمدينة حماة تحت ذريعة القضاء على هذه الجماعة. قضى كيلو عامين في سجن “المزة” سيئ الصيت في العاصمة دمشق، في تجربة اعتقال أولى. بعد خروجه من المعتقل، غادر كيلو البلاد إلى فرنسا حيث قضى أعواماً قبل أن يعود إلى سورية في عام 1989، مواصلاً عمله في الحقلين السياسي والثقافي، معارضاً للنظام.
في عام 2000، كانت سورية على موعد مع حدث أمِل السوريون أن يؤدي إلى تغيير سياسي جذري في بلادهم بعد عقود من الاستبداد، إذ “مات الديكتاتور” كما صرخ المعارض رياض الترك بعد وفاة حافظ الأسد منتصف ذاك العام. وفي مشهد لا يفارق ذاكرة السوريين بعد أكثر من 20 عاماً على حدوثه، ورث بشار الأسد السلطة عن أبيه، وهو ما أغرى معارضين وفي مقدمتهم ميشيل كيلو، للقيام بنشاط سياسي ضمن ما سمّي حينها بـ”ربيع دمشق” الذي شهد ظهور المنتديات السياسية، و”لجان إحياء المجتمع المدني”. نشط كيلو عام 2000 بكتابة المقالات التي كانت تنشر في صحف لبنانية عدة، والتي شرّح فيها الفساد السياسي والاقتصادي الذي كان ينخر سورية بعد أكثر من 30 عاماً من حكم استبدادي أمني قمعي. لم يدم “ربيع دمشق” طويلاً، إذ ألغت الأجهزة الأمنية كل المنتديات السياسية واعتقلت الكثير من المعارضين، في رسالة واضحة أن شيئاً لم يتغيّر في “سورية الأسد” لا شكلاً ولا مضموناً، وأن سياسة بشار الأسد لن تختلف عن سياسة أبيه في كمّ الأفواه، لمنع أي نشاط يدفع باتجاه “تثوير” الشارع السوري.
عام 2005، وقّع معارضون وتيارات سياسية وقوى تغيير معارضة على وثيقة سياسية تحدد سبلاً لنقل سورية من الاستبداد إلى الديمقراطية، عُرفت لاحقاً بـ”إعلان دمشق”، ثم وقّع ميشيل كيلو مع معارضين “إعلان بيروت – دمشق” في 2006. اعتقل النظام في ذاك العام كيلو وآخرين، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية”. وفي مرافعة شهيرة له أمام ما كانت تسمّى بـ”محكمة أمن الدولة”، قال كيلو: أنا الإنسان والمواطن الحّر ميشيل بن حنا كيلو وغالية عوض، الذي ليس نصير أي جماعة في لبنان أو سورية، وليس نصير أي حزب قائد أو منقاد وأي ثورة، سواء أكلت وطنها أم أكلت ناسها، لأنني نصير وطني الصغير سورية ووطني العربي الكبير، ونصير كل مواطن فيهما، نصير الحرية والديمقراطية.
في ربيع 2011، تحقق ما عمِل ميشيل كيلو وسوريون آخرون عليه طيلة 30 عاماً، حيث اندفعت جموع السوريين إلى الشوارع، معلنة انتهاء “زمن الخوف” وبدء ثورة شعبية جرت كثير من الدماء تحت جسورها بسبب الحرب التي شنّها النظام على طالبي التغيير في البلاد. تطلّع المنتفضون إلى ميشيل كيلو منذ الأيام الأولى للثورة، فلم يخيّب ظنهم كما فعل الكثيرون من المنتمين إلى اليسار السياسي، فأعلن تأييده المطلق للثورة، وهو ما عرّضه إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية هددت حياته، لأن هذه الأجهزة تدرك أهمية الرجل واتفاق السوريين عليه. غادر كيلو البلاد خشية التنكيل به، كما فعل أغلب المعارضين المعروفين، ليؤسس مع مجموعة من المعارضين في العاصمة المصرية القاهرة عام 2012 “المنبر الديمقراطي السوري”. ثم أطلق كيلو هيئة “سوريون مسيحيون من أجل العدالة والحرية”، بهدف “ردم الهوّة بين المسيحيين وبقية الشعب…” كما قال حينها. ولكن هذه الخطوة لم تجد ترحيباً من الأوساط السورية المعارضة بسبب الخشية من تكريس واقع بدأ يتشكل في سورية، يقوم على العصبيات القومية والدينية والمذهبية.
عام 2013 انضم كيلو إلى “الائتلاف الوطني السوري” الذي كان تأسس في العاصمة القطرية الدوحة، ثم أسّس في العام ذاته أيضاً “اتحاد الديمقراطيين السوريين”. انسحب كيلو لاحقاً من المشهد السياسي المؤسسي، مستقراً في باريس، حيث تفرغ للكتابة في صحف عربية، تحديداً “العربي الجديد”، التي ظل يكتب فيها عموداً أسبوعياً ثابتاً حتى رحيله، لتشريح ما جرى خلال عقد كامل من عمر الثورة، ولحضّ السوريين على الاستمرار فيها لأن “النظام، مع حليفيه الإيراني والروسي، لم ينتصر”، وفق ما جاء في الرسالة الأخيرة لكيلو الذي قضى أغلب عمره محارباً الاستبداد، مدافعاً عن الحرية. قبيل وفاته بأيام، طالب كيلو السوريين بالإبقاء على التصميم والتوق لـ”استعادة سوريتنا بالخلاص من هذا النظام الذي صادر أكثر من نصف قرن من تاريخ بلدنا”، مضيفا: “شعبنا يستحق السلام والحرّية والعدالة… سورية الأفضل والأجمل بانتظاركم”.
————–
رحل كيلو منفيًّا، قبل أن يقطف بنفسه ثمار نصف قرن من العمل السياسي المعارض لتقويض نظام الاستبداد في سورية، ولكنه شهد على مدى أكثر من عشر سنوات انتفاضة السوريين التي لطالما حلم بها، وقضى من أجل الوصول إليها سنوات طويلة من عمره في معتقلات نظام الأسد الأب والابن.
وُلد كيلو في مدينة اللاذقية عام 1940، وعاش طفولته في أسرته وبرعاية من والده الذي كان واسع الثقافة. تلقى كيلو تعليمه في اللاذقية وعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
تقلّد كيلو، منصب رئيس “مركز حريات” للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سورية، وهو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وأحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق، وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري في المكتب السياسي، ومحلل سياسي وكاتب ومترجم وعضو في اتحاد الصحافيين السوريين.
كان لكيلو حصة من ترجمة بعض الكتب الفكرية السياسية إلى اللغة العربية منها كتاب “الإمبريالية وإعادة الإنتاج” و”كتاب الدار الكبيرة”، و”لغة السياسة” و”الوعي الاجتماعي”.
مع انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011، تحقق ما عمِل كيلو وسوريون آخرون عليه طيلة 30 عامًا، حيث اندفعت جموع السوريين إلى الشوارع، معلنة انتهاء “زمن الخوف” وبدء ثورة شعبية جرت كثير من الدماء تحت جسورها بسبب الحرب التي شنّها النظام على طالبي التغيير في البلاد.
وتطلّع المنتفضون إلى ميشيل كيلو منذ الأيام الأولى للثورة، فلم يخيّب ظنهم كما فعل الكثيرون من المنتمين إلى اليسار السياسي، فأعلن تأييده المطلق للثورة، وهو ما عرّضه إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية هددت حياته، لأن هذه الأجهزة تدرك أهمية الرجل واتفاق السوريين عليه.
وترك كيلو البلاد خشية التنكيل به، كما فعل أغلب المعارضين المعروفين، ليؤسس مع مجموعة من المعارضين في العاصمة المصرية القاهرة عام 2012 “المنبر الديمقراطي السوري”. ثم أطلق كيلو هيئة “سوريون مسيحيون من أجل العدالة والحرية”، بهدف “ردم الهوّة بين المسيحيين وبقية الشعب…” كما قال حينها.
ولكن هذه الخطوة لم تجد ترحيبًا من الأوساط السورية المعارضة بسبب الخشية من تكريس واقع بدأ يتشكل في سورية، يقوم على العصبيات القومية والدينية والمذهبية.
وفي عام 2013 انضم كيلو إلى “الائتلاف الوطني السوري” الذي كان تأسس في العاصمة القطرية الدوحة، ثم أسّس في العام ذاته أيضًا “اتحاد الديمقراطيين السوريين”.
ترك كيلو لاحقًا، المشهد السياسي المؤسسي، واستقر في باريس، ثمّ تفرغ للكتابة في صحف عربية، تحديدًا في صحيفة “العربي الجديد”، التي ظل يكتب فيها عمودًا أسبوعيًا ثابتًا حتى رحيله، لتشريح ما جرى خلال عقد كامل من عمر الثورة، ولحضّ السوريين على الاستمرار فيها لأن “النظام، مع حليفيه الإيراني والروسي، لم ينتصر”، وفق ما جاء في الرسالة الأخيرة لكيلو.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88
أكثر من الف مقال ومادة لميشيل كيلو في موقع “صفحات سورية”
مقالات ميشيل كيلو قبل 2011
مقالات من عام 2011 حتى عام منتصف عام 2018
510 مقالا لـ”ميشيل كيلو اثناء الانتفاضة الشعبية في سورية وحتى منتصف عام 2018
مقالات من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2020
121 مقالا لميشيل كيلو وحوالي 40 مقالا آخر في ملفات أعدها الموقع “صفحات سورية”
مقالات “ميشيل كيلو” منذ بداية 2021
==================
أهم حوارات ميشيل كيلو
حوار مع المفكر والصحفي ميشيل كيلو 2 أذار 2008
ميشيل كيلو :المهمة الآن أن نُخرج الموقوفين من السجون وأن نستأنف المسيرة 24 أيار 2009
حوار مع ميشال كيلو: متى تنتج الثورات العربية أحزابها ؟ 6 أذار 2011
ميشال كيلو : درعا كسرت الصمت ومطالب المعارضة تصب في مصلحة النظام 12 أيار 2011
ميشيل كيلو: “المناخ الدولي لا يتماشى مع الطريقة التي تعالج بها المشاكل في سوريا 13 أيار 2013”
ميشيل كيلو لـ «الراي»: لم يحدث حوار فعلي مع شعبان 15 أيار 2011
ميشيل كيلو خائف… على بلده 29 أيار 2011
الكاتب السوري ميشال كيلو: الدور التركي هو دور مهم ويؤشر إلى دور عالمي 5 حزيران 2011
ميشيل كيلو للعرب اليوم : في سورية لا نريد حوارا يغطي حلا أمنيا 19 حزيران 2011
المعارض والباحث السوري ميشيل كيلو: سورية على اعتاب تدخل غربي من الناتو وتركيا 4 أيلول 2011
ميشيل كيلو: الحل الأمني يقود الى تدخل دولي 2 تشرين الأول 2011
كيلو: على المجتمع المدني أن ينقلب على حكم الأسد 22 كانون الثاني 2012
ميشال كيلو: في البلدان العربية كانت الثورة “فاعلية مجتمعية” وليس حزبية او نخبوي 12 آب 2012
ميشال كيلو في “رأس العين”: حتى لا تكون نقطة انطلاق الحرب الأهلية في سوريا 17 تشرين الثاني 2013
كيلو لـ«الجمهورية»: فشل «جنيف 2» سيُفجّر الصراع الدولي 19 أيار 2013
ميشيل كيلو : لن نتمكن من هزيمة النظام وذهبت إلى السعودية وقابلت بندر 16 حزيران 2013
ميشال كيلو: لا أتوقع تسوية في جنيف 16 حزيران 2013
ميشال كيلو: النظام لن يحتمل الضربة… والأيام بيننا 8 أيلول 2013
ميشال كيلو: المقترح الروسي تضييع للوقت واليوم لم يعد هناك إلا الخيار العسكري 15 أيلول 2013
ميشيل كيلو: لن أذهب بالشروط الحالية إلى جنيف وإن قطعوا رأسي 6 تشرين الأول 2013
ميشيل كيلو: إذا فشل جنيف فستدخل سوريا في حرب مذهبية واسعة النطاق 1 كانون الأول 2013
ميشيل كيلو: سنصلح الائتلاف شاء من شاء 27 نيسان 2014
ميشال كيلو: هذه الانتخابات لا تعطي للأسد الشرعية 8 حزيران 2014
ميشيل كيلو: قيادة الائتلاف تستفرد بالقرارات والنظام حقق انتصارات كبيرة بفضل المعارضة 6 تموز 2014
حوار غسان المفلح مع ميشيل كيلو 17 أب 2014
==========================
مقالات مختارة بعناية في رثاء “ميشيل كيلو“
—————————-
هكذا أتذكر ميشيل/ اكرم البني
مرتان، وقبل أن أتعرف على ميشيل كيلو مباشرة، ملأني اسمه بفرح وفخر: المرة الأولى، في سجن المزة عام 1979 من خلال ما سمعناه كسجناء عن حديثه الجريء مع ممثلي الجبهة الوطنية التقدمية خلال جولاتهم للتعبئة ضد الأخوان المسلمين، حين جاهر بانتقاداته للظلم والاعتقال السياسيين، وطالب فوراً بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، وسمى رابطة العمل الشيوعي التي كنا ننتمي اليها بالإسم؛ والمرة الثانية في خريف عام 2000 عندما حصلنا ونحن في سجن صيدنايا على ما سمي بيان الـ99 مع إشارات توحي بأن أحد العاملين الرئيسين عليه كان ميشيل كيلو، والذي شكل بنقاطه الديمقراطية الحاسمة خياراً تعويضياً لنا، كمعتقلين شيوعيين، لتجاوز حالة انعدام الوزن التي عشناها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
لكن لم يخطر ببالي بعد خروجي من المعتقل عام 2001 أن يكون ميشيل كيلو أحد الزوار المهنئين. وحين بادر أحد الأصدقاء للتعريف باسمه انتابتني لوهلة حالة ارتباك ووجل، ازدادت انكشافاً بعد أن قدم لي بعض الأوراق والبيانات التي أصدرتها لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وأضاف: “موقعك معنا ونتشرف بمشاركتك” وهي عبارة كانت بلا شك من بين دوافع قراري الانضمام إلى لجان إحياء المجتمع المدني.
أن تقول لجان إحياء المجتمع المدني يعني أن تقول ميشيل كيلو، ويعني أن تتفهم حرصه على استنباط المهام البسيطة غير المنفرة لتشجيع الناس على المشاركة في الشأن العام وتخليصهم من الخوف والتردد، كما يعني أن تحترم رغبته في منح الأولوية لإيصال أكبر قدر من الأفكار والمعارف لاستنهاض قوى المجتمع المدني وتمكينها من وعي وإنتاج نفسها كهيئة عامة مستقلة نسبياً عن التمثيلات السياسية، ويعني أيضاً التحلي بالشجاعة للاستمرار في النشاط الإحيائي بعد انتكاسة “ربيع دمشق” وعودة المناخات الأمنية والاعتقالات وحظر المنتديات الثقافية، ويعني أخيراً أن تقدر جيداً مثابرته لتنمية وحماية التشابكات التي نشأت بين أوساط واسعة من المثقفين، بما في ذلك المساهمة في إذابة جدران الجليد بين قوى سياسية معارضة، عرفت الجفاء والقطيعة كما تطوير التواصل والتعاضد للمرة الأولى بين الفاعليات العربية والكردية.
لم أشعر مع الصديق ميشيل للحظة بأنني أمام شخص غامض أو مختلف. وأعترف بأن ثمة دوافع لا تزال خفية دفعتني دفعاً لاحترام هذا الرجل، ليس منها فارق العمر على أهيمته، بل ربما روحه القريبة من كل قلب ووضوح دماثته في التعاطي والتفاهم مع الآخر. بل ما زاد هذا الاحترام وداً وتقديراً، أفكاره التي استمر في المجاهرة بها برغم ما تعرض له من ضغوط وتهديدات، وثباته في الدعوة لوحدة كافة مكونات المجتمع السوري القومية والدينية من أجل بناء وطن أفضل وأجمل لكل أبنائه، واضعاً قضية الحرية والمساواة والكرامة في مركز الاهتمام وأمام العديد من المهام السياسية التي كانت ولا تزال تفتن القوى السورية المعارضة.
وطيلة معرفتي بهذا المناضل بدت لي هذه الروح أصيلة وصادقة. لم ألمس في أدائه أية محاولة لاغتنام الفرص. بل أشهد أنه وفي مختلف الأزمات التي تعرض لها، أو تعرضت لها قوى المعارضة السورية، كان يبدي إصراراً لافتاً على وحدة الهموم وأولوية المعالجة المشتركة.
” دق المي بتبقى مي”… أطلق ميشيل عبارته ونحن نهم بالخروج من مكتب أحد قادة المعارضة بعد أن جرى تحويل النقاط الديمقراطية الأربع التي طرحتها لجان إحياء المجتمع المدني إلى ما يشبه برنامجاً سياسياً يتضمن قضايا تتعلق بالوطن والقومية والاقتصاد، وكأنه بهذه العبارة يريد التأكيد على أن عمل المعارضة لن يخرج من ثوابتها الأيديولوجية والسياسية نحو اعتناق الهم الديمقراطي أساساً. كان يرغب في الإبقاء على المحتوى الديمقراطي للمشروع الذي قدمته لجان إحياء المجتمع المدني تحت اسم إعلان دمشق، بصفته ساحة أوسع لجمع المختلفين فكرياً وسياسياً ولإدارة الصراع بطريقة سلمية، لكن إخفاقه لم يثنه عن متابعة النشاط داخل الهيئات الأولية التي تشكلت تحت اسم “إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي”.
لم يخف عن السلطات السورية دور ميشيل كيلو المحوري في إنشاء وإظهار ليس فقط إعلان دمشق، وإنما أيضاً “إعلان دمشق بيروت، بيروت دمشق” الذي طالب بعلاقات متكافئة بين لبنان وسوريا، فكان رد فعلها مباشراً وقاسياً، وتم اعتقاله مع عدد من المثقفين، وإحالتهم إلى محكمة جائرة قضت بسجن ميشيل كيلو مدة ثلاثة أعوام بعد اتهامه زوراً بنشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية…
لم يتأخر ميشيل عن إعلان انحيازه لثورة السوريين ودعم حراكهم السلمي ضد ما عانوه من قهر وتمييز وفساد. كانت تملؤه العواطف الجياشة والحماسة لشعب قرر أخيراً كسر أغلاله، فشجع الالتحاق بصفوف المتظاهرين والتفاعل معهم وخلق قنوات لمدهم بالخبرات والشعارات المناسبة. بدا كأن الحياة دبت بقوة في نشاطاته فلم يتردد في تفعيل اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الناشطين بغض النظر عن خلفياتهم، وساهم بدور رئيس في محاولات لم شمل المعارضة وأولها، تشكيل ما يعرف اليوم بـ”هيئة التنسيق الوطنية” ثم انضم إلى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” قبل أن ينسحب احتجاجاً على تقدم ظواهر التسلط والتفرد والفساد والخضوع لإملاءات الآخرين.
وإذا كانت السمة الأبرز من سمات ميشيل كيلو هي منح الديمقراطية الأولوية التي تستحقها على كل شيء، فهناك أبعاد إنسانية وأخلاقية متميزة عنده وما أكثرها، أن في ما لمسته من تميز سياسي في رفضه فكرة الخلاص الذاتي، وتأكيده، رغم ما تعرض له من قمع وسجن وحصار وتشويه سمعة، أنه واحد من المثقفين الذين لن يتخلوا عن دورهم في مواجهة قوى التسلط والعنف والإرهاب أياً كان نوعها، وأن الأوقات العصيبة التي يمر بها المجتمع السوري هي بالذات الأوقات الأنسب كي يثبتوا روحهم التواقة للديمقراطية والحرية والمواطنة.
مع غيابك نكون قد فقدنا الروح الأعمق إيماناً والأكثر ثقة بمهمة الثقافة والمثقفين في خلاص السوريين، من تطلع إلى دور إنقاذي يلعبه المثقفون تجاه مجتمعهم في أوقات المحن والأزمات أو في لحظات التحول العاصفة، ربما كنوع من الإقرار بالوظيفة الخاصة بهم في إعادة بناء وعي نقدي وأفكار جديدة يفترض أنهم أقدر المعنيين ببنائها، أمام ضعف السياسة وعجز أو تردد رجالاتها، فمن غيرك من أتعبنا بتكرار السؤال عن حال المثقفين وما يمكن أن يفعلوه مع تسارع انكشاف أزمات مجتمعهم والفشل البين للمشروع السياسي في وقف التدهور الحاصل أو الإمساك بزمام المبادرة، وهل نتجرأ بعد غيابك على ممارسة النقد اللازم لتقصير غالبية المثقفين في نصرة الديمقراطية عندما أحجموا لفترات طويلة ولأسباب متنوعة عن معارضة أساليب الاستبداد وانعدام الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم يظهروا قدراً كافياً من التضحية والشجاعة للاعتزاز بالحياة الديمقراطية وحرية التفكير والإبداع والتمسك بمعاييرها، وتالياً للدفاع عن التكافؤ والعدالة والمساواة بين البشر وبين الشعوب والأمم ضد مختلف أشكال التمييز القومي أو الطائفي أو المذهبي؟
ومع غيابك كيف يمكن أن نواجه ونفحم تلك الأبواق الإعلامية المشبعة بالكذب والحقد التي تدافع عن أنظمة لا تزال تعامل شعوبها كالقطعان أو كالجرذان، تستسهل قتل ناسها بأعصاب باردة وتدبج الأكاذيب حين تهتز عروشها عن المؤامرات التي تتعرض لها، أو لنرد على العجزة الذين يتهربون من مسؤولياتهم ومن أدوارهم تحت ذرائع شتى، أهمها الادعاء بقصور مجتمعاتنا عن إنجاز التحول السياسي والديمقراطي، والذين يتأقلمون ويدعون الآخرين إلى التأقلم مع غياب الحقوق والحريات، مع الفساد، مع انعطاب المواطنة، مع التمييز والترويج لتقاليد العيش بين أطلال التخلف وتشجيع النزعات الطائفية والمذهبية!.
هو ليس مديحاً، مع أن ميشيل كيلو يستحقه، القول بأن هذا الصديق كان من أبرز الأصوات الديمقراطية التي أضاءت ليل سورية الحالك، صوت رفض الانتهاز، لم تكن حساباته تكتيكية بل مبدئية يحدوها رفضه مقايضة دولة الحرية والمواطنة بأي مكسب أو عطاء زائف، كان متخوفاً دائماً من وأد المسار الديمقراطي برايات إيديولوجية استبدادية مغلقة ومفرغة من أي بعد إنساني أو حضاري.
رحلت في الزمن الصعب، الزمن الذي ضاع فيه الوطن وتشوهت فيه ثورة السوريين العظيمة، الزمن الذي يستحق أن نستخلص منه الدروس والعبر، ولعل أهمها، ما ينفع الناس يمكث في الأرض أما الزبد فيذهب جفاءً…
لبنان الكبير
——————-
ميشيل كيلو منارة السوريين الأخيرة/ بشير البكر
رحل ميشيل كيلو وترك خلفه فراغا كبيرا في حياة السوريين. رحيل ليس مثل أي رحيل آخر، بل هو رحيل الخسارة القاسية التي تقع مثل زلزال بقوة عالية. لحظة رحيل كيلو تشبه الفشل في دخول دمشق وإسقاط النظام، وهي مثل خروج الثورة من مدينة حلب الذي أسس للانهيار اللاحق. عشنا لمدة شهر على أمل أن يتجاوز كيلو الوضع الصحي الصعب ويعود معافى. فسوريا بحاجة إلى هذا الرمز أكثر من أي وقت مضى. هو من بين قلة من الرجال والنساء الذين يمثلون رأس المال الرمزي للسوريين.
تاريخ كيلو هو تكثيف حي ودقيق لمسار المعارضة السورية بأبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية، وتجربته تتقاطع في صورة واضحة مع الخط البياني لحركة المجتمع السوري منذ تسلم حزب البعث السلطة سنة 1963. ماركسي وعروبي، إصلاحي وجذري، وسطي ومتطرف، مناور ومبدئي. يعيش داخل السياسة بمعناها الكلاسيكي ويحيا تمظهراتها وتقلباتها من موقع المثقف العضوي الذي ميزه غرامشي عن بقية أصناف المثقفين، من خلال اعتناقه لثقافة المعنى. صاحب دور لا يجلس في برج عال ليراقب الشارع، يسير أمام الجماهير ماداً لها يده كما يقول بريخت. ومن بين قطاع واسع من المثقفين السوريين الكبار، انحاز كيلو إلى السياسة ببعدها اليومي، ولم يعتكف بعيداً ليتفرغ للتنظير، رغم أنه لا يقل جدارة عن رفاق مفكرين عاصرهم وعايشهم وصادقهم مثل ياسين الحافظ وإلياس مرقص. لذا، بقي أقرب إلى محترف السياسة بمعناها السياسي المباشر من أمثال رياض الترك، رغم أنه لم يمكث طويلاً في تجربة العمل الحزبي، حيث بدأ مشواره شيوعياً، ومن ثم انتقل إلى الضفة الأوسع التي تكونت بفضل عملية التحول والنقد والمراجعة التي قام بها الترك للحركة الشيوعية السورية الرسمية، وأدت إلى انشقاق الحزب الشيوعي السوري إلى حزبين: التيار الأول ظل سوفياتياً وقريباً من السلطة يقوده خالد بكداش، والتيار الثاني عربي قاده رياض الترك، وانخرط في صف المعارضة الجذرية منذ سنة 1973 حينما رفض المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية التي ألّفها النظام من عدة أحزاب بقيادة حزب البعث الذي خولته المادة الثامنة في الدستور “قيادة الدولة والمجتمع”.
كلما تأزم الوضع السوري، كان موقف كيلو جديراً بالنظر ومحط اهتمام، لأنه “باروميتر” لمن يريد أن يقرأ درجة حرارة ومستوى الضغط لدى السلطة والمعارضة على السواء. اعتادت السلطة اعتقاله في كل مرة شعرت فيها بأنه تجاوز الحدود، أما هو فقد درج على الذهاب نحو الحد الأقصى كلما رأى أن اللحظة السياسية تقتضي المواجهة. وهنا يجدر التوقف أمام مشهدين رئيسيين في تجربة كيلو: الأول هو اعتقال كيلو في غمرة مواجهة السلطة مع الإخوان المسلمين في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات، وفي حينها لم تتورع الأجهزة الأمنية عن نسبه إلى الإخوان المسلمين. ولمن لا يعرف تاريخ تلك الحقبة، كان ذنب كيلو الرئيسي هو صرخته الشهيرة بأن “الوطن في خطر”، وكان رأيه أن مصدر الخطر يأتي من طرف السلطة أولاً، لأنها مارست لعبة العنف. وغني عن القول أن السلطة كانت تنتظر منه موقفاً يدين الإخوان المسلمين فقط. والمشهد الثاني هو اعتقاله في سنة 2006، وبررت السلطة سجنه لمدة ثلاث سنوات على خلفية توقيعه لبيان “إعلان دمشق بيروت” الذي صدر في أيار 2006، ممهوراً بتوقيع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين، وحمل نظرة مشتركة إلى نوعية العلاقات بين الشعبين السوري واللبناني، التي ساءت كثيراً بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي حقيقة الأمر، لم يكن ذلك هو السبب الوحيد لاعتقاله، وربما كان القطرة التي جعلت الكأس يطفح، والسبب هو مواقفه بعد ختم تجربة “ربيع دمشق” بالشمع الأحمر سنة 2000، وثارت السلطة على كيلو على إثر نشره لمقال في 2006 تحت عنوان “نعوات طائفية”، جرى النظر إليه على أنه تحريض طائفي، وانعكس ذلك من خلال الردود والانتقادات التي نالها من طرف كتاب الحكم، وكلها دارت من حول رمي كيلو بتهمة الطائفية التي وجدت لها السلطة صيغة غريبة “إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية”.
كيلو، وفي مقالة له بعنوان “قصة اعتقالي واتهامي”، كتبها وهو في السجن يقول: “واليوم، وبعد سبعة أشهر على وجودي في السجن، أراني أتساءل: هل صحيح أنه تم توقيفي بسبب إعلان دمشق بيروت، لا، ليس إعلان بيروت/ دمشق سبب اعتقالي. هذه قناعتي… وإذا كان هناك من يريد الانتقام مني…؛ فإنني أتفهم موقفه وإن لم أقبله، مع رجاء أوجهه إليه هو أن يمتنع عن وضعه تحت حيثية القانون والقضاء، كي لا يقوض القليل الذي بقي لهما من مكانة ودور”.
الجانب القاسي من تلك التجربة يتمثل في أن كيلو جرت محاكمته أمام المحكمة العسكرية. وفي أيار 2007 أصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بعد إدانته بـ”نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية”.
ليس هناك من يعوض غياب ميشيل كيلو في الخارج ولا في الداخل، هو علم بين الأجيال كافة.
مشروع ديموقراطي عروبي وطني تقدمي، رائحة ياسين الحافظ وإلياس مرقص وجورج طرابيشي مؤسسي الفكر السوري الجديد. الفكر المعارض النقدي بعد عقود من التنظير الماركسي الدوغمائي الغوغائي الستاليني، والقومي البعثي العاطفي والعنصري في بعض الأحيان. وجاء هؤلاء من قراءة عميقة للفكر النقدي العالمي المتحرر من سطوة المدرسة السوفياتية، والمنفتح على القراءة الجديدة في أوائل سبعينيات القرن الماضي مع روجيه غارودي (واقعية بلا ضفاف) والشيوعية الأوروبية التي مثلها الحزب الشيوعي الإيطالي وتبعه الإسباني والفرنسي.
مع رحيل ميشيل كيلو يفقد السوريون واحدا من الأعمدة القليلة التي كانوا يتكئون عليها في السراء والضراء، حين يفرحون وعندما يبكون. هو منارة عالية وبوصلة وطنية ليس لسوريا فقط، بل كان يرى ويقّدر أهمية التقاطعات في الإقليم، ما بين سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر. يدرك العلاقة بين الديموقراطية ومحاربة الاحتلال والاستيطان، والأطماع الأجنبية في العالم العربي الآتية من الشرق والغرب معا.
تلفزيون سوريا
———————–
وداعاً ميشيل كيلو… الإنسان النبيل الجريء الحرّ…/ ماجد كيالي
في رحيل هذا الرجل خسرت السياسة السورية واحداً من ألمع سياسييها، وصانعيها، هكذا نعاه سوريون كثر…
كان يوم رحيل ميشيل كيلو (أبو أيهم)، في “منفاه” الفرنسي (الإثنين 19/4/2021)، بمثابة يوم من وجع، ومن حزن، ومن قهر، للسوريين، في كل أماكن وجودهم، لشعب أضحت حياته كلها حكاية من وجع وحزن، وقهر مع كل الأهوال التي أضحى يعايشها منذ عشرة أعوام.
قضى ميشيل كيلو بعد صراع مع “كورونا”، امتد لأكثر من ستة أسابيع في المستشفى، وبرحيله فقد السوريون واحداً من نبلائهم، وواحداً من أهم الذين كسروا الخوف في قلوبهم، وواحداً من أهم الذين زرعوا في روحهم فكرة التمرد على نظام الأسد، وواحداً من أهم الذين رفعوا ألوية الحرية والمواطنة والديموقراطية، لدرجة يمكن القول معها إن سيرة هذا الرجل ارتبطت بسيرة شعبه، أكثر من أي شيء آخر، إذ لا يمكن العثور على همّ خاص، أو شخصي له في كل سيرته، لكأنه جُبِل من السياسة، أو لكأن حياته جُبِلت بحكاية شعبه ومصيره.
منذ بدأ وعيي السياسي، في مطلع السبعينات، تعّرفت إلى اسم ميشيل، كشخصية سياسية معارضة للنظام، في بلد لا يسمح بأي معارضة، وظللت أسمع به، كشخص يتحدّى السلطة، ويكسر هيبتها، عرفته شخصاً شجاعاً، يحارب ويصارع برأيه وفكره وثقافته، يعرّف ذاته بدلالة شعبه، وبدلالة توقه للحرية والتغيير، فيلاحق ويسجن ويفرج عنه ثم يسجن. بعدها تعرفت إليه كصديق، فوجدته شخصاً نبيلاً، ووفياً، وغاية في التواضع، والانفتاح، مع اختزانه تجربة كبيرة وثقافة عالية ومتميزة، وفوق كل ذلك فقد كان على قدر عال من التوادد مع الآخرين، والتخفيف عنهم، وبث الأمل في قلوبهم.
ولد ميشيل كيلو في مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا على الساحل، عام 1940، ودرس الصحافة في مصر وألمانيا، ثم عمل في منتصف الستينات في وزارة الثقافة في سوريا (قسم الترجمة) وقدّم كتباً في الفلسفة والأدب والسياسة.
وفي مختلف المراحل، ومنذ شبابه، خاض ميشيل تجربة العمل السياسي من دون أن ينتسب إلى أي حزب سياسي (باستثناء فترة قصيرة في الحزب الشيوعي السوري)، لا سيما أن معظم الأحزاب السياسية كانت مدجنة في إطار ما يعرف بـ”الجبهة الوطنية التقدمية”، في واقع يهيمن فيه “حزب البعث”، وبالأصح يحتكر، كحزب للسلطة أو للرئيس، السياسة والحياة السياسية، في بلد لا يعرف حقوق المواطنة، ولا حرية الرأي والتعبير.
وفي الإجمال، كان ميشيل وطنياً سورياً بامتياز، كما كان عروبياً، بالمعنى الثقافي، وليس بالمعنى القومجي أو العصبوي، وبالطبع كان يسارياً، أي مع حقوق الفقراء والشغيلة، بانحيازه لهم ضد الظلم والفساد والاستبداد. وطبعا فهو كان يسارياً من النمط النقدي، إذ كان قريباً من الياس مرقص، مثلاً، ويوافقه في دحض الجمود الأيديولوجي، ونقد التبعية للمركز السوفياتي.
ولعل الدور الأبرز الذي اضطلع به ميشيل كان دوره مع آخرين في تحدي نظام الأسد، وتعريته، في ذروة تسلطه، وظهر ذلك جلياً في مداخلة له، مشهورة، في “اتحاد الكتاب العرب” (1979)، حين كان عمره 39 سنة. بعد ذلك كان من أبرز نشطاء ما سمي “ربيع دمشق”، والمنتديات السياسية، و”لجان إحياء المجتمع المدني”، التي برزت بعد رحيل حافظ الأسد، والتي سرعان ما تم إجهاضها. عام 2005، وقّع ميشيل مع معارضين آخرين وثيقة سياسية سميت “إعلان دمشق”، ثم وقّع “إعلان بيروت- دمشق” (2006)، وقع عليها في حينه عشرات المثقفين السوريين واللبنانيين، وهي الوثائق التي أحدثت صدى سياسياً واسعاً في سوريا وخارجها. وبالنتيجة فقد اعتقل ميشيل في عهد الأسد الابن (2006) مع آخرين، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، وكان سبق له أن اعتقل، أيضاً، في مطلع الثمانينات في عهد الأسد الأب.
في سيرته إبان الثورة السورية، لم يكن ميشيل كيلو يوماً في أي موقع مسؤول في المعارضة، من الناحية العملية، وربما أن القوى الخارجية التي تحكمت بالتشكيلات السورية كانت تفضل تهميش تلك الشخصية، وغيرها ممن هو مثله من شخصيات المعارضة التاريخية، وجلب آخرين ليس لهم تاريخ، ولا تجربة، من الذين يمكن التحكم أو التلاعب بهم. هكذا فإن ميشيل لم يدخل “المجلس الوطني السوري”، الذي تأسس أواخر 2011، ولكنه عام 2013 دخل “الائتلاف الوطني السوري”، بعد عام على تأسيسه، ثم غادره أواخر 2016، بعد خيبة أمل كبيرة. لكن خروج ميشيل لم يأت في فراغ، إذ أصدر مع مجموعة من رفاقه وثيقة نقدية (أواخر 2016) لمسارات الثورة السورية، وارتهاناتها الخارجية، ولطرائق عملها، مؤكداً ضرورة القطيعة مع الرهانات الخاطئة والمضرة لتلك الثورة، وضمنها الارتهان للتدخلات الخارجية، والعسكرة، بمعنى تشكل قوى إقليمية لفصائل عسكرية، والتطييف، الذي يعني التغطي بالإسلام، وتحويل الائتلاف إلى كيان مغلق لمجموعة من الأشخاص.
بعد خروجه من الائتلاف لم يترك ميشيل العمل العام، إذ ظلت روحه مشغولة بالثورة، وكان بمثابة “دينامو” لجماعات كثيرة كانت تتواصل معه، وظل في تلك الفترة يواصل كتابات الرأي، التي يضمنها أفكاره، وقبل أسابيع صدر له كتاب من ثلاثة أجزاء عنوانه: “من الأمة الى الطائفة… سورية في ظل حكم البعث”، وكتاب آخر عنوانه: “الصراع على سوريا الثورة السورية وبيئتها الدولية”، وكان قبل عام نشر رواية “دير الجسور”.
عرف ميشيل بصدقه، وطيبته، وبسرعة بديهته، وكواحد من أفضل المتحدثين في السياسة السورية، وكانت قصته الشهيرة مع ذلك الطفل الذي ولد في السجن، مع أمه المعتقلة (كرهينة بسبب زوجها الذي هرب من الاعتقال) جد موجعة وحزينة، كأنها قصة سوريا كلها، إذ أخذه أحد السجانين ليحكي قصة لهذا الطفل (بات عمره وقتها أربعة أعوام)، وعندما بدأ يحكي له عن العصفور سأله الطفل: ايش يعني عصفور؟ وعندما قال له عصفور على الشجرة سأله ماذا تعني شجرة؟ خاب أمل ميشيل انه لم يستطع سرد قصة على الطفل، وتألم وبكى، وأبكى كل من استمع إليه، أنى تحدث عن تلك القصة.
في رحيل هذا الرجل خسرت السياسة السورية واحداً من ألمع سياسييها، وصانعيها، هكذا نعاه سوريون كثر، فكتبت الإعلامية سميرة المسالمة: “رحل صوت سوري حر مزق جدار الخوف منذ زمن بعيد وبقي وفياً لحريته وسوريته وحلمه… وداعاً ميشيل كيلو وأعان الله عائلتك وأصدقاءك وكل محبيك على احتمال هذا الفراق المؤلم في غياهب الغربة الحارقة”. وكتب الفنان عبد الحكيم قطيفان: “رحل كبيرنا وجميلنا وبهي الروح… رحل ميشيل كيلو رجل الحرية والوطنية والكرامة والطيبة والتضحية ومناهضة الطغيان… رحل نبيل الروح والمقاصد… في حضرة غيابك المؤلم والفاجع والمرير… يحضر الدمع والصمت وتتنكس كل الرايات والأعلام والهامات ويبقى فقط صمت الفجيعة ودهشتها… أبكيك لأن غيابك لا يعوض… أبو أيهم الجليل وداعاً”. أما سوزان لبابيدي فكتبت: “في يوم ما قلت لوالدي أتمنى أن يكون هذا الرجل رئيساً لسورياً… وداعاً ميشيل كيلو”. ورثاه محمد السلوم بقوله: “عندما تمضي نصف قرن من عمرك وأنت تقارع الاستبداد والدكتاتورية… ثم تموت في الغربة من دون أن تقرّ عيناً برؤية وطنك حراً… فاعلم أن من يبكيك اليوم إنما يبكي نفسه… وطنه… غربته… بقايا الحلم!”.
هذا رجل سيبقى في الذاكرة، كإنسان، وكسياسي، وكمثقف… فهذا شخص لا يمكن نسيانه في تاريخ سوريا، وكواحد من صانعي هذا التاريخ… وداعاً ميشيل… وداعاً… ستبقى في قلوب السوريين والفلسطينيين واللبنانيين وذاكرتهم.
درج
————————
ميشال كيلو يترك الباب مفتوحاً/ فايز سارة
عرفت #ميشال كيلو قبل نحو خمسين من وفاته، كنت شاباً صغيراً، يخطو خطواته الأولى نحو العمل العام، عرفته في حينها كاتباً صحافياً، أتابع كتاباته، وذهبت معرفتي به الى شكل واقعي في التسعينات، وصرت زميلاً في الصحافة والكتابة من دون التخلي عن متابعته بصفته كاتباً وصحافياً، تعجبني مقالاته، ويعجبني ما عرفته عنه من سخونة موقفه في معارضة النظام، والتي كان أحد أثمانها اعتقاله المعروف عام 1979 لانتقاده المباشر والعلني لنظام الأسد الأب في لقاء عام على مدرج جامعة دمشق.
عندما بدأ ربيع دمشق يشق الطينة الصلبة لنظام الأسد الوريث، بدأ شوط جديد من علاقتي بميشال كيلو، حيث أضيف إلى ما سبق نكهة الرفقة، التي لم تكن مجرد رفقة على نحو ما يتصوّر البعض، بل رفقة بالمعنى العميق الذي كنت أصف المصنفين في حلقتها بأنهم آخر وأهم الأصدقاء لما تبقى لنا في الحياة.
وسط تلك الرفقة ذهبنا مع رفاق آخرين في تجربة لجان إحياء المجتمع المدني، التي ألقت حجارتها في المستنقع السوري الآسن الذي خلقه نظام الأسد، يحيط به حياة السوريين، وانتقلنا منه الى المشاركة النشطة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي إطاراً لتحالف واسع للمعارضة ضد نظام الأسد، ثم قمنا بالتشارك مع مثقفين وكتاب وأكاديميين لبنانيين بإطلاق إعلان دمشق – بيروت بيروت – دمشق من أجل أنسنة العلاقات السورية اللبنانية وتصحيحها شعبياً ورسمياً، بعدما استباحها نظام الأسد وأدواته اللبنانية، ودمّر أخوة الشعبين وتجاور البلدين.
لم أشارك ميشال ورفاقاً آخرين المبادرات، التي وصفها كثيرون بأنها “مهمة” وغيرها من الأوصاف الكبيرة فقط. بل تشاركنا ألم الاعتقال نحو عامين ونصف عام انتهت أواسط عام 2010، وتشاركنا معاناة التغريبة السورية شتاتاً في فرنسا وتركيا، ثم عشنا معاً في “التجربة المرة” في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، التي سعى كثيرون عن قصد أو من دون الى خرابها وإفشالها، وخرج كل واحد منا من التجربة في وقت متقارب، من دون أن نتشاور في ذلك، بل كنا نعاني “أزمة علاقات بينية” بسبب الائتلاف ونتائج تجاذباته وصراعاته، كما خضنا معاً تجربة ولادة الهيئة العليا للمفاوضات قبل أن نغادر الائتلاف بعيداً عن علاقات التبعية واستسهال مسار العمل الوطني، وإلحاقه بما تيسّر من أجندات إقليمية ودولية بحجج واهية ولا معنى لها.
في السنوات الخمس الأخيرة، وكما درجت علاقاتنا، كانت الهموم المشتركة محور علاقاتنا، وفيها لقاءات ومبادرات وأفكار وأوراق هنا وهناك، كان الهمّ الرئيس في كل ما سبق، تقييم ما جرى، واستخراج دروسه، ودراسة الواقع في أبعاده المحلية والإقليمية والدولية، ووضع تصوّر لما ينبغي القيام به من خطوات للوصول الى حل سوري يحقّق السلام، ويخلّص السوريين من الاستبداد والدكتاتورية والدم مجسدين بصورة نظام الأسد، حل يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.
وإذ يغادرنا ميشال في موته، فإنه يترك تلك المهمة بين يدي الأصدقاء والرفقة القريبين والمقربين للعمل عليها، ليس فقط وفاءً لذكراه وسيرته، بل للضرورة التي تمثلها في حياة السوريين وبلدهم اليوم وفي المستقبل.
————————–
رحل “العم ميشيل” من أراني يوماً الطريق إلى الحرية/ نجيب جورج عوض
قد يكتب كثيرون في المستقبل كل أنواع الاجتهادات النقدية والتقريضية في مواقف وسيرة ميشيل كيلو، أحد أبطال سوريا المناضلين والوطنيين الكبار الذي رحل عنا بعد صراع مرير مع القاتل المعولم، فيروس كورونا. لن أفعل هذا لا هنا ولا في أي مكان آخر. ما أخطه بقلبي وذاكرتي، قبل أصابعي ونقراتها الحزينة على مفاتيح الكومبيوتر، هو شهادة شخصية وجدانية للتاريخ عن شخصٍ عظيم مر في حياتي وترك بعضاً من عطرٍ لا يزول أبداً. شهادة عن “الخال أبو أيهم” أو “العم ميشيل” كما عرفته وناديته كل عمري وكما أودعه اليوم. عن معلمنا الكبير وصوتنا النضالي والثوري الحر الذي كنا نرى فيه أملاً بأن يبقى لنا حضور على خريطة هذا المشرق التعيس والقذر الذي يرحل أجمل ما فيه ويبقى وحوشه أحياء.
أستطيع أن أعود بالذاكرة عشرات السنين إلى الوراء في مسيرة معرفتي بالخال أبو أيهم. فهو ابن عمة والدي (عمتي غالية) وابن العائلة القريب من الجميع والذي يعرفه الجميع فيها من صغيرهم لكبيرهم والذي يعرف جميعهم بالاسم والسيرة. لا يرحل من ذاكرتي أبداً صورتي أنا الولد الصغير الذي لا يتجاوز طوله عشرات السنتمرات وهو يقف وينظر عالياً فوق رأسه بعيون فضولية متأملاً هذا الرجل ذو البنية الضخمة والصوت العميق الواثق والنبرة القوية والعالية والصارمة في كلامه الذي كان يزورنا في بيتنا حين كان يتردد على مدينة اللاذقية ليجلس مع والدي ويتبادلان أطراف الحديث في الشأن العام والسياسة، مع اختلاف آرائهما وميولهما السياسية ولكن مع اتفاقهما معاً على مساوئ ومفاسد حال البلد والنظام. والدي الذي اختار “السترة” والصمت وممارسة المهنة وتأمين عيش وكرامة عائلته بهدوء وابتعاد كلي عن السياسة (التي انخرط فيها عروبياً وناصرياً من دون حدود في شبابه)، والعم ميشيل الذي لم يتوقف يوماً عن الانخراط حتى النخاع في الشأن العام والسياسة، والذي دفع أثمان وطنيته وثوريته الباهظة لسنوات طوال منذ تجرأ وقال “كي يرضى أبونا الذي في السموات” (عن الأسد الأب) وصولاً إلى “نعوات سورية”، المقالة التي لم يحتملها الأسد الابن وجهازه الأمني.
إن أنسى فلن أنسى ذاك اليوم المشؤوم في مطلع التسعينات حين فقدنا عمي الوحيد الذي توفي في دبي مصاباً بسرطان اللوكيميا. كان يوماً قاسياً وصادماً علينا جميعاً. أذكر حين عاد والدي من مطار دمشق إلى اللاذقية محضراً معه نعش أخيه، عمي فايز، إلى مثواه في مدينته الأم. يومها كان أبو أيهم مع والدي في تلك الرحلة ووصل معه إلى منزلنا. لن أنسى يومها حين اقترب مني وأنا أحاول أن أمسح دموعي المنهمرة من عيني وقال لي بصوته العميق والواثق: “لاتبكي يا خال. كون رجاّل”.
تتوالى السنون ويستمر أبو أيهم في نضاله وثورويته التي لم تهتز ولم تحنها سنوات الاعتقال العديدة والمراقبة والتضييق، لا بل زادت وتيرة عمله المدني والسياسي والشعبي حدة وقوة ووضوحا وجرأة مع وصول ابن الطاغية إلى وراثة السلطة. يومها، في مطلع الألفية الجديدة، كنت قد بدأت رحلتي نحو الدراسات العليا في بريطانيا وكنت أزور سوريا في العطل والأعياد. في تلك الفترة، ومع إلقائه لخطاب تسلم الرئاسة، دعا بشار الأسد كل كتاب ومثـقفي سوريا لمساعدته في عملية إصلاح البلد والنظام وتسليط الضوء على ما يجب فعله للسير بسوريا نحو المستقبل، كما ادعى. يومها صدقنا جميعاً هذه الكذبة الكبيرة ورحنا نكتب ونحاول التعبير عن رأينا. كان أبو أيهم في طليعة الجميع ملهماً ومرشداً بتأسيسه وقيادته للجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ومتابعته لنشر البيانات التاريخية مع رفاقه المثقفين والوطنيين السوريين واللبنانيين وعدم توقفه أبداً عن الكتابة والتعليم لأمثالي من الآلاف عما يحتاجه البلد كي يخرج من ماضيه الأسود وواقعه الكارثي. وكان كلما نزل إلى اللاذقية وعرف أنني موجود فيها أيضاً، وبرغم وقته الضيق ومشاغله وعشرات الناس الأكثر أهمية وقيمة الذين كان يلتقيهم، كان يتصل بي بمنتهى التواضع والاحتضان الأبوي ويتحدث إلي بمنتهى التشجيع والثـقة ويدعوني كي نلتقي ونتحدث. تكررت لقاءاتنا مابين أعوام 2003 و2009 في اللاذقية وفي منزله في دمشق، في مناسبات قليلة جداً كنت أزور فيها المدينة التي لم أشعر فيها يوماً بالأمان ولم أحبها. وكانت آخر مرة التقينا فيها في مدينتنا الحبيبة، اللاذقية. يومها، قمنا مع الصديق الغالي (صديقنا الحبيب المشترك، منذر مصري) بجولة على الأقدام بين آثار مدينة أوغاريت العتيقة (الصورة). تأبط العم ميشيل ذراعي وراح للمرة المئة يحدثني عن فكر وآراء وذكريات صديق عمره ومعلمه، كبير اللاذقية، ألياس مرقص، والذي لطالما حسدت العم ميشيل على أنه تعلم على يديه وعرفه وتحاور معه شخصياً.
أهم لقاء بيني وبين أبو أيهم، والذي ترك بصمة لا تمحى على قصة حياتي كان في صيف عام 2002. كنت وقتها في اللاذقية وكان العم ميشيل يقضي فترة صيفٍ فيها أيضاً. يومها التقينا في صومعتي الصغيرة القريبة من منزلنا حيث كنت احتفظ فيها بكتبي وأسطواناتي وأوراقي وأشيائي وأختلي بها للكتابة والقراءة والسماع للموسيقا الكلاسيكية كلما رزت العائلة في المدينة. يومها تحدثـنا عن المجتمع المدني ونشاطه وأحوال البلد، وسمحت لنفسي بأن أعطيه مقالة كتبتها بعنوان “الإصلاح وتوريث الخوف”. كانت يدي ترتجف وأنا أتجرأ أن أعطي خربشاتي السياسية المبتدأة للخال المعلم والمفكر الكبير والناشط المرجعي الذي لطالما كنت ألتهم كل ما يكتب وأقرأه كتلميذ ينهل من أمهات كتبٍ، كتلك التي كنت أنهل منها في مكتبات بريطانيا في عملي على الدكتوراه. أعطيته المقال فقرأه بصمت وابتسامة خفيفة على وجهه وقال لي: “ممتاز. سأشاركه مع بعض الزملاء والأصدقاء إن سمحت لي وأعود إليك بانطباعاتهم. لا تنشره حالياً”. وهذا ما كان. عاد هو إلى دمشق وعدت أنا إلى بريطانيا، لأعود بعدها ببضعة شهور مجبراً إلى سوريا في عطلة أعياد الميلاد بسبب استدعائي للتحيقيق الأمني في فرع أمن الدولة بسبب المقال المذكور والتهديد باعتقال عائلتي إن لم أمثل شخصياً. سأتعرض للتحقيق الأمني في السنوات التالية وسأتبع الكتابة دون توقف وأنا أعلم أن العم ميشيل كان يقرأني ويتصل بوالدي في غيابي ليعبر له عن إعجابه بما كتبت. ولكن، هذه البداية المقترنة بإيمان أبو أيهم بما كتبت وضعت قدمي على سكة كل المواقف والخيارات السياسية والوطنية التي أخذتها في حياتي حتى هذه اللحظة، والتي لم أندم عليها أبداً ولم أنظر فيها ولا مرة واحدة للخلف. كنت أحاول أن أنظر إلى الزاوية نفسها التي اعتقدت أن العم ميشيل ينظر إليها.
في سنوات الثورة، كان من الطبيعي أن أخطو على مسار الانتفاض نفسه على النظام الذي سار عليه العم ميشيل مع كثير من المعارضين والوطنيين السوريين من رفاقه. اختلفت مع الخال أبو أيهم في الرأي حول تفاصيل وجزئيات ووجهات نظر ومواقف وتمنيت لو لم يتخذ بعضها. لكنني بقيت على تواصل معه على قدر استطاعتي وكلما كان هذا ممكناً في زحمة انشغالاته وغرقه العميق بشؤون الثورة والمأساة السورية وفي خضم غرقي لقمة رأسي بالأكاديمية وشجون الشرق الأوسط والمأساة السورية. قبل أسابيع قليلة من رحيله الفاجع، تحادثـنا عبر الواتساب. اتصلت به بعد أن سمعت من يقول أن الفيروس القاتل قد أصابه. يومها تحادثـنا معاً وكأننا مازلنا جالسين نحتسي الشاي في صومعتي القديمة في مدينة اللاذقية: هو بصوته الواثق والعميق وعقله النير واحتضانه الحميم، وأنا بارتباكي وجلوسي في محضر معلم كبير وأب فكري وثوري كمن يستمع ليتعلم. يومها سألني عن الأهل، والدتي وأختي وأخي وعن أخبارهم. وسألني أيضاً عن أخباري الخاصة. ثم طلب مني بكل محبة أن أرسل له آخر كتبي ومؤلفاتي بالعربية كي يقرأها، ووعدني أن يرسل لي كتابه الأخير عن تجربة البعث في سوريا. وعدته أنني بعد أن أنهي انتقالي إلى أوروبا سأرسل له نسخة من كتابي العربي الأخير “أحفورات الفهم، تاريخانيات المعنى” وأنني سأزوره في باريس إن أمكنني ذلك. بعدها تتالت الأسابيع وأنا أترك له رسائل صوتية على الواتساب والتقط كلمات قليلة تكتب لي من طرفه عن حالته. آخر ما تلقيته من طرفه على الواتساب كانت رسالة تقول “مددوا لي العلاج اليوم لأسبوعين”. تركت له رسالة صوتية رداً على ذلك وتمنيت له العودة السريعة بيننا. في صباح 19 من نيسان 2021، أخبرني صديقي وأخي الغالي، وسيم حداد، بالخبر المفجع والأليم: رحل ميشيل كيلو، “الخال أبو أيهم”، معلمنا الكبير من بيننا.
“عم ميشيل”، سامحني، لم أستطع أن لا أبكيك… لم أستطع أن أكون هذا الرجل الذي شجعتنني أن أكونه قبل ستٍّ وعشرين سنة. أعلم تماماً أنك لم ترغب يوماً أن تعرِّف نفسك بدلالة خلفيتك المسيحية بل بدلالة سوريتك الأصيلة وفقط سوريتك. وأعلم أنك لم ترد يوماً أن تقول أنك تنطق باسم المسيحين، فأنت دوماً ومراراً نطقت باسم كل السوريين، من وافقك ومن اختلف معك، من آمن بفكرك ومن تهجم عليك. ولكن، عليك أن تعلم وأنت في عليائك الأبدية بأن مسيحيي سوريا الأحرار والثوار (وهم حقيقيون وليسوا وهماً)، أحببت ذلك أم لم تفعل، فقدوا اليوم الصوت المسيحي الحر والثوري والوطني الحقيقي والرائد بينهم. كان صوتك يضعنا على الخريطة ويذكر الآخرين بأننا موجودون وأننا نشارك في أوجاع وأحلام ومظلوميات ونضال كل السوريين في سعيهم نحو الحرية والدولة والعدالة والديمقراطية والمستقبل. كنا نرد على من يتهم المسيحيين تجنياً بأنهم منبطحون للنظام المجرم والمستبد ضد غالبية الشعب السوري بالقول “ميشيل كيلو هو صوتنا المسيحي في قلب النضال ضد النظام وهو من آباء الثورة السورية الذي يثبت أننا قلباً وقالباً من ومع أهل سوريا وسنبقى”. لم تكن يا “عم ميشيل” صوت سوريا، كل سوريا، الحر والمناضل فقط. كنت أيضاً، علمت أم لم تعلم، صوت المسيحيين الشرفاء والوطنيين أيضاً في قلب ضعفهم وقلة حيلتهم وعجزهم وتهميشهم الدائم من قبل البعض. رحل اليوم صوتك الذي كان يظللنا جميعاً ويحمل أحلامنا ويعلمنا كثيرا حتى في اختلافنا معه ونقدنا له وتمنينا عليه أن يأخذ بعضاً من خطا مختلفة. فكرك العميق والعلمي والثاقب والدولتي الذي فقدناه من بيننا هو من أكثر الأفكار التي ستحتاجها سوريا في المستقبل، إن كان لها مستقبل ما. فقدناك اليوم سيداً ومعلماً لأصوات الحرية والثورة السورية والمسيحية على حد سواء في سوريا. فقدت سوريا اليوم أحد أهم وطنييها ومناضليها الكبار الذين عاشوا حياتهم لأجلها قولاً وفعلاً وفكراً وممارسة وأثمانا… إلى حضن الملكوت أيها المعلم…. سأشتاق لصوتك العميق والواثق. سأفتقد للأمل الذي كنت تعطيه لي وأنت بعيد وناءٍ وغارق في معاركك…. لكنني لن أترك ذاك الدرب الذي حدثتني للمرة الألف عنه وأنت تبتسم وعيناك تلمعان بالثـقة في منتصف ظهيرة يوم جميل تمشينا فيه وأنت تتأبط ذراعي في مدينة أوغاريت العتيقة على كتف البحر المتوسط واللاذقية التي عشقناها معاً.
تلفزيون سوريا
—————————-
ميشيل كيلو استثناء في السياسة السورية/ عمار ديوب
سُجِنَ عدّة مراتِ، ككل سياسي في سورية. لكنّه سُجِنَ لأنّه الأكثر بحثاً عن التغيير في سورية في جمهورية الخوف. منذ عقودٍ، تداول السوريون سرّاً، وكل السياسة الجادّة كانت سرّيّة، أشرطة تسجيل قديمة، وكان فيها كلمةً لميشيل كيلو وأخرى لممدوح عدوان وكلمات لآخرين في مؤتمر لاتحاد الكتاب العرب (السوري) في 1979. رفضوا فيها ديكتاتورية النظام في لحظة الحرب الطائفية في سورية. كانت جرأة كبيرة حينها أن يُعلنوا موقفاً رافضاً للنظام، وقد راح يتأسّد ويغلق كل منافذ الحريات حينها. بعد عام 2000، ساهم السياسي المخضرم في مختلف الفعاليات السياسية البارزة: بيان الـ99، بيان 1000، وثيقة إعلان بيروت دمشق، وإعلان دمشق، لجان المجتمع المدني، وهكذا. مع انطلاقة الثورة 2011، كان دوره بارزاً في كل تشكيلات المعارضة، وبدءاً بهيئة التنسيق الوطنية، وليس انتهاء بالمنبر الديمقراطي والائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة. لديه ترجمات كثيرة، وأبحاث فكرية، ونشرَ أخيرا عن دار موزاييك في إسطنبول كتابا يتناول حقبة الجنرال حافظ الأسد وحكمه.
شخصية سياسية كبيرة، ولكنها لم تُعط يوماً دوراً سياسياً يذكر. كانت محط تضييق ومراقبة واستدعاء من أجهزة الأمن. هكذا عاش سني حياته، وأيّة حياة هذه؟ وحينما ضاقت السبل بأمثاله، اختار المنفى ليتابع نضالاته. نعم، ظلمه نظام بلاده ظلماً شديداً. ظُّلمَ الرجل الذي لم يتأخر عن دعم التحوّل الديمقراطي وقيادته في بلاده سورية، ثم وافته المنيّة، ولم تتحقق أمنياته أول من أمس، 19 إبريل/ نيسان 2021.
يؤخذ على الراحل تحالفه مع أحمد الجربا، أحد رؤساء الائتلاف الوطني للثورة والمعارضة، وكذلك مساهمته في تأسيس تيار “سوريون مسيحيون من أجل العدالة والحرية”، وإشادته بشباب تابعين لجبهة النصرة، وهناك كثرة مساهمته بتشكيل منابر وقوى سياسية والانسحاب منها، وأيضاً تصريحات غير ديمقراطية بحق الأكراد. تلك المآخذ، ربما بالنسبة لسياسيٍّ كميشيل كيلو إضافات نوعيّة لدعم التغيير في سورية، وجاءت في لحظةٍ غير مدروسة جيداً. ليس ميشيل وحده من فكّرَ بهذه الطريقة، بل كثرٌ من قيادات المعارضة السورية. إذا كانت الأمور بخواتيمها، فميشيل والآخرون أخطأوا، وكان عليهم أن يكتبوا نقداً لتجربتهم المهمة تلك؛ فالواقع يقول إن الفئات التي دعمها استفادت منه، وليس العكس، بينما الرجل استقال منذ 2016 من “الائتلاف”، واختار العمل مستقلا. وهذه مأساة كبرى أن تترك شخصية كميشيل كيلو وأمثاله العمل السياسي، وتتصدّره شخصياتٌ لا تاريخ لها، ولا قيمة اعتبارية أو مكانة إقليمية، وكذلك ليس لها باع في العمل السياسي والثقافي. وهذا لا يتناقض مع ضرورة أن تتنحّى الشخصيات الكبرى عن العمل السياسي لقياداتٍ شابّة، وليس لمن أصبحت قياداتٍ في المعارضة!
كانت مقالاته أخيرا في صحيفة العربي الجديد، كلّها دعوات من أجل إعادة الروح إلى المعارضة، والعودة إلى العمل السياسي الوطني، وعدم ترك الوضع السوري بأيدي الخارج، الإقليمي والدولي، وهذا صائبٌ للغاية، حيث كل تسويّةٍ ستتحقق، وبغياب المعارضة الفاعلة ستكون كارثة على الوضع السوري، فكيف ستضمن الدول الكبرى مصالح الشعب السوري، وهي تتدخل في دولة ذلك الشعب، وتسيطر عليها وتحتلها، وتتقاسم مراكز النفوذ فيها!؟
على فراش الموت، كتب رسالة إلى السوريين كافة. أراد منها ألا يستكين السوريون للخارج، وللإحباط مما آلت إليه أوضاعهم. حثَّ فيها على الإنصات “والانصياع” لكل صاحب فكر ورأي، والأخذ بآرائهم، وهذا بالضرورة يقتضي نقدها ونقاشها وتطويرها، وليس كما حلّل كثر على صفحات التواصل الاجتماعي؛ أن ميشيل يُملي على السوريين ما عليهم التقيد به من دون شرط أو رفض أو انزياح! فيا سادة، كان الرجل يكتب وهو في سكرات الموت، فكيف ستكون مفرداته؟
كان هدف الرسالة التخلص من العمل الشلّلي والحزبي الضيق، والسعي نحو توحيد السوريين، فليس من الممكن أن ينتصر السوريون، أو يكون لهم موقع قدمٍ في المستقبل، وهم مقسّمون. فكرته سليمة، ومن الخطأ تكرار الفشل، في تجارب العمل السياسي الرافض “الائتلاف الوطني ..”، أو بقية التشكيلات السياسية المكرّسة، كهيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري وسواهما. العمل من أجل تمثيل جديدٍ للمعارضة أو تطوير القديم المذكور منها، وتغيير توجهاتها والتخلص من التبعية لهذه الدولة أو تلك، وإعادة إطلاق سياساتٍ جديدةٍ على أسس وطنية ومواطنية، نقول إن هذا هو الأساس الصلب لأيِّ عملٍ جادّ وفاعل ومؤثر، وإيقاف ما آلت إليه الأوضاع السورية من مآسٍ وتشتت واستنقاع ومراكز نفوذ للدول الخارجية.
غادرتنا شخصية سياسية مهمة في تاريخ سورية. لن يتم تعويضها بسهولة أبداً، فهو من المبادرين القلّة، بعد عام 2000 لتفعيل العمل السياسي الديمقراطي السوري. نعم، حان الوقت من أجل تشكيل مؤسساتٍ جديدة للمعارضة، تتجاوز الأخطاء التي وقع بها الراحل ميشيل كيلو ذاته، وهي التحالف مع أيّة فئاتٍ سياسية رافضة للنظام، أو قادرة على تحشيد فئاتٍ جديدةٍ لصالح الثورة. أشكال الفشل التي عاشتها الثورة والمعارضة وسورية تقتضي معارضة جديدة، ومشروعا سياسياً جديداً، يتجاوز الانقسامات بين السوريين، ومهما كانت أسباب الانقسام.
خسرت سورية قبل عام 2000 بسجن ميشيل كيلو وتهميشه، واختيار المنفى بضع سنوات بعد عام 1984 بدلاً من محاورته، وكذلك رفضت محاورته، حينما خرج من سورية بعد عام 2011، وبوفاته أيضاً تخسر سورية الكثير الكثير. خسرت رجلاً كان في وسعه أن يساهم في المرحلة الانتقالية، والتحوّل الديمقراطي والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
الطغيان يقضي على أفضل ما في البلاد من رجال وثروات وثورات ومعارضات. إنه يسلمها إلى الغزاة إن رفضه أهلها. يرحل ميشيل كيلو وسورية أصبحت محتلة. هذه الحقيقة تجاهلتها المعارضة، وميشيل كيلو منها، آخذين بالاعتبار إمكانية أن تغير روسيا البوتينية من سياساتها وعدم التصعيد معها، ولكن هذا غير ممكن؛ فروسيا أو تركيا أو أميركا أو إيران وسواها تنفذ سياساتٍ تخضع لمصالحها، وليس لمصالح الشعوب المتعثرة والمُحتلة.
العربي الجديد
———————————
ميشيل كيلو في رواية أخرى/ أرنست خوري
لكثرة ما صنع ميشيل كيلو واشتغل وأنجز وأخفق في حياته الدسمة، ربما يستحسن التعاطي مع رحيله بمشاهد متقطعة، وخصوصاً عندما لا تدعي معرفة شخصية معمقة به، بل مجرد متابعة لتطوره في يساريته وعروبته وديمقراطيته ونضاله ضد الاستبداد وإصراره على رؤية سورية حرة ديمقراطية بأي ثمن وبأي وسيلة. لدى الآلاف ما يقولونه عن ميشيل كيلو، سورياً وعربياً وفلسطينياً وشخصياً وثقافياً. وربما تفيد بعض السطور في الإضاءة على ميشيل كيلو المتحمّس حماسة الأطفال لولادة إطار سوري معارض جامع، إحدى نسخه تقررت تسميتها “المجلس الوطني السوري”، وقد شهدت باريس على الأيام الأولى لما بعد ولادته في اسطنبول، ما بين قاعة قدمتها “لوموند ديبلوماتيك” وأخرى سمحت بلدية ضاحية مالاكوف جنوب غربي العاصمة الفرنسية باستخدامها للاجتماعات ولمعالجة الخلافات الكثيرة، والتي نذر ميشال كيلو نفسه لمحاولة حلحلتها، لعله يتمكّن من إزاحة بعض النرجسيات، ولو مؤقتاً، على اعتبار أن المهمة المطروحة هي بحجم تكوين جسم سوري جامع يحظى بالاعتراف المحلي والدولي ليكون بديلاً ديمقراطياً تعددياً لنظام بمستوى إجرام آل الأسد والعصابة والتحالف العالمي الداعم له.
بضعة أيام من “ملاحقة” ميشيل كيلو صحافياً في باريس خريف عام 2011، وبضعة لقاءات بيروتية في صحيفة السفير أوائل أيام الثورة السورية، كافية ليفهم المرء عن أي طينة من الناس نتحدّث، وعن أي شعور بواجب النضال يحرك سبعينياً (في حينها) ليتغلب على متاعبه الصحية لعلّه يفلح في رؤية ما سعى لمشاهدته قبل رحيله: سورية حرة وديمقراطية، سورية بلداً لمواطنين، بلداً لـ”شعب حقاً” مثلما كتب في رسالته ــ وصيته إلى السوريين (العربي الجديد، 9 إبريل/ نيسان 2021). كانت الدنيا تعجّ بالحلم الكبير الذي صدّقنا أنه سيتحقق في غضون أشهر بالفعل. كان ميشال كيلو خارجاً لتوّه من سورية بعدما اقتنع باستحالة “المعارضة من الداخل” في الجحيم الأسدي. وصل إلى فرنسا حيث شهد على محاولات تمتين المجلس الوطني السوري، لعله يكون نسخة منقحة من منظمة التحرير الفلسطينية، بأخطاء أقل وبأدوات أكثر وبأدنى معدل ممكن من الانتهازية. تأخر وصول ميشيل كيلو لكنه وصل في النهاية، وكان ذلك كافياً لبث مشاعر ارتياح عند كثيرين، سوريين وغير سوريين، ذلك أن للرجل مصداقية معتبرة حتى عند من لا تعجبهم مواقف كثيرة تُحسب له أو عليه. نادراً ما غاب ميشيل كيلو عن منتدى حكماء أو خبراء أو مستشارين له علاقة بالثورة السورية وبشؤونها، ونادراً ما رفض طلب كتابة مقال عن الثورة في أيامها الأولى خصوصاً، وقد كان من أوائل من شرّحوا في ملحق “السفير العربي” البيروتي أسباب ثورة حمص على ذلك المحافظ اللعين، إياد غزال، “صديق بشار الأسد، ومحل ثقته منذ الطفولة والمدرسة” مثلما كتب ميشال في يوليو/ تموز 2012.
دعك من نضال الرجل في السجن وخارجه وتماسكه وتكييف تفكيره مع التحولات. دعك مما أنجزه وعجز عنه، سورياً وعربياً وفلسطينياً وفكرياً وصحافياً. دعك من كل هذا وذاك. تكفي مراقبة الحرص الذي تملّك ميشيل كيلو في أيام تأسيس كل الهيئات السورية المعارضة على اعتبارها احتمال خلاص من الجحيم. هذا الحرص الذي يزيل كل أنا متضخمة، هو من بين أكثر ما ينقص الثورة السورية اليوم ربما. يكفي ميشيل كيلو فخراً أنه شرح للعالم ماذا يعني نظام الأسد بقصة يفهمها كل عقل إن كان حامله بني آدم: طفل سوري مولود في الزنزانة لأم مسجونة عقاباً لوالدها الإسلامي. يحاول ميشيل المعتقل أيضاً أن يقص عليه حكاية عن عصفور فيسأله الطفل عن معنى العصفور. يحاول إيجاد الجواب بأنه ذلك الذي يطير على الشجرة، فيطحنه الاستفسار عما هي الشجرة؟
لم يرحل ميشيل كيلو إلا بعدما تحرّر من كل الأكاذيب التي تلصق باسم فلسطين والمقاومة كوصفة سحرية لتأبيد الاستبداد. تعبيره الغاضب كان لـ”العربي الجديد” الحصة الوازنة منه على شكل عمود أسبوعي صبيحة كل يوم سبت منذ سنوات. الرحلة اختتمها برسالة وصايا للسوريين كللها بحكمة ترسّخت لديه ربما في أيام السجن بجوار رياض الترك: لن تصبحوا شعباً واحداً ما دام نظام الأسد باقياً.
العربي الجديد
——————————–
ميشال كيلو… مزايا المعارضة السورية وعيوبها/ محمد سيد رصاص
تعرّفت على ميشال كيلو في يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، عندما اعتُقلت من قِبَل فرع المنطقة للأمن العسكري في دمشق (فرع العدوي). كان ميشال معتقلاً قبلي بخمسة أيام، في إطار الحملة على الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، التي بدأت في السابع من الشهر المذكور. كنّا معصوبي الأعيُن ومكبّلي الأيدي من الوراء، وبعضنا من الأمام، لأيام وليالٍ متواصلة في مهجع بطول عشرة أمتار وعرض أربعة أمتار، حيث تَكدّس ما يقارب المئة من المعتقلين. لم يعذّبوا ميشال بوسائل التعذيب المعتادة، ربّما احتساباً لكونه كاتباً مشهوراً وقد طَبَقت شهرته الآفاق عندما تكلّم قبل عام بجرأة كبيرة مع لجنة «الجبهة الوطنية التقدّمية»، التي قابلت المثقّفين والكتّاب، بل اكتفوا بجعله يقف تحت إشراف حارس المهجع لمدّة ثمانٍ وأربعين ساعة على رجليه، حتّى انهار من الإنهاك ووقَع مغشيّاً عليه بعدما تورّمت رجلاه. كان صلباً في التحقيق الذي أُجري معه، لذلك عاقبوه بذلك الإجراء التعذيبي.
عندما خرجت من السجن بعد خمسة عشر عاماً، وكان ميشال قد قضى سنتين في السجن ترجم فيها عدّة كتب، منها كتاب «الديموقراطية الأوروبية» (تأليف أرتورو روزنبرغ) عن الألمانية، والذي نشرته وزارة الثقافة السورية عام 1984، أخبرني عبد الله هوشي (الذي تولّى قيادة الحزب السرّية من عام 1987 إلى عام 1998 – حتّى خروج رياض الترك من السجن -، علماً أنه سبق عبد الله في القيادة محمد منير مسوتي بعد اعتقال رياض في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1980) بأن ميشال ينتظرنا أنا وإيّاه على طعام العشاء في بيته قرب المستشفى الفرنسي في دمشق. لاحظت أن ميشال يومها يجمع الكرم والطيبة والمحبة والذكاء والثقافة في مزيج لافت، وقد أخجلني يومها أمام عبد الله عندما أطرى على أدائي في التحقيق وصمودي في التعذيب وفي ظروف المهجع، وقد تفاجأت لاحقاً بأن الكثيرين قد سمعوا ذلك منه. أدخلني ميشال، في حزيران/ يونيو 1998، إلى عالم الصحافة اللبنانية عندما أعطى مقالاً مكتوباً لي عن «التحديث والتغريب» عند صموئيل هنتنغتون، إلى جوزف سماحة، وكان آنذاك في جريدة «السفير». في ذلك الشهر، لفتت نظري حادثة عندما كتب ميشال مقالاً لجريدة «الموقف الديموقراطي» (وكنت أشتغل في تحريرها ولي فيها 25 مقالاً، منها افتتاحيتان، بين عامي 1996 و2000، وكانت تصدر عن أحزاب «التجمّع الوطني الديموقراطي»)، يرحّب بخروج رياض الترك من السجن، وقد لاحظ عبد الله هوشي أنه لا يجوز نشر المقال بدون إطلاع رياض عليه، لذلك طلب منّي الذهاب إلى حمص ومقابلة أبي هشام، الذي رفض المقال، وخصوصاً قول ميشال إن الحزب ورياض عند انشقاق عام 1972 في مواجهة خالد بكداش، كانا متأثّرَين بعبد الله العروي وياسين الحافظ والياس مرقص. وقال رياض، يومها، إنه لم يقرأ كتب الثلاثة، وغالبية قيادة الحزب (ماعدا الدكتور فايز الفواز) مثله. في ذلك اللقاء مع رياض، قال لي أبو هشام إن عنده معلومات وصلت إليه حديثاً عن أن ميشال وعبد الله والدكتور جمال الأتاسي هم وراء وثيقة صدرت قبل شهرين، تدعو إلى تحويل التجمّع بأحزابه الخمسة من تحالف إلى حركة واحدة، وهو ما كانت ترفضه غالبية قواعد وكوادر وبعض قيادات الحزب، قبل أن يتمّ تفشيل المشروع من قِبَل رياض بعد أشهر، خصوصاً أن الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) كان يرى، على ضوء الوفاة المتوقّعة للرئيس حافظ الأسد بحكم مرضه، أن العهد الجديد يجب أن تتجهّز له المعارضة بعدّة جديدة أبعد وأقوى من «التجمّع»، والاتجاه نحو جبهة عريضة تضمّ الديموقراطيين والإسلاميين. وقد بدأت، فعلاً، اتصالات الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) مع «جماعة الإخوان المسلمين»، في أوائل عام 1999، وليس كما يقول البعض من الذين لا يعرفون شيئاً، أثناء أحداث حزيران/ يونيو 1979 – شباط/ فبراير 1982.
كان ميشال صاحب مقولات سياسية هي أقرب إلى المغامرة الفكرية، مثل طرحه في أربع مقالات نُشرت في «النهار»، في العُشر الثالث من شهر آب/ أغسطس 2000، أن العهد االجديد في سوريا يضم «جناحاً إصلاحياً» يمثّله الرئيس الجديد، و«جناحاً محافظاً» من الذين كانوا في العهد السابق. وأَذكر بأنّي عندما رددت عليه، في مقال تمّ نشره في «النهار» في يوم 10 أيار/ مايو 2002 بعنوان «أزمة المعارضة السورية»، قام ميشال بقطع العلاقة الشخصية معي. في المؤتمر التداولي الذي عقده الحزب، في شهر آذار/ مارس 2001، كرّر ميشال طرح مقالاته الأربع، وهو ما أيّده فيه الكثيرون في المؤتمر، وبعض قيادات أحزاب التجمّع الذين كانوا ضيوفاً في المؤتمر. كما طرح ميشال مقولة جديدة بأن «الحزب هو برنامجه السياسي، وأن الحزب يكتسب هويّته من برنامجه السياسي ولا يكتسبها من المنهج المعرفي التحليلي الذي يقوم بتوليد البرنامج السياسي»، في متابعة لطرح وثيقة نيسان/ أبريل 1998، التي دعت إلى توحيد أحزاب خمسة مختلفة أيديولوجياً في حركة سياسية واحدة. كان كلام ميشال إرهاصاً مبكراً لتنظير اتّبعه التاركون السوريون للشيوعية والماركسية، عندما ردّدوا مقولته تلك وأرفقوها مع مقولة «موت الأيديولوجيات».
في فترة 2000 – 2001، كان ميشال رئيسياً في «لجان إحياء المجتمع المدني»، وكان الحزب الشيوعي (المكتب السياسي) يدعم تلك الحركة للمثقّفين الذين كان الكثيرون منهم على صلات بالحزب وأوّلهم ميشال. وأَذكر عندما صرّح ميشال بأن «بيان الألف» حصد تواقيع تتجاوز الألف، وتحدّاه في ذلك إعلامي وكاتب موالٍ للسلطة بأن يكون لديه أكثر من مئة توقيع، كيف استنجد ميشال بالحزب الذي قام بتأمين أكثر من ألف توقيع بُعثت له عبر شركة «القدموس» من اللاذقية وحلب، بعدما كان ميشال لا يملك آنذاك، بالفعل، كما أقرّ لبعض قيادات الحزب، أكثر من عشرات التوقيعات.
كانت لميشال حركات قفز من هنا وهناك، مثل قفزته من طرح «الجناح الإصلاحي والجناح المحافظ»، إلى المراهنة على الخارج لإحداث تغيير داخلي، عندما صرّح، قبل أسبوع من غزو الأميركيين للعراق، بالتالي: «نعم لشكل التدخّل الدولي الذي قد يخلّص الشعب العراقي من رجل دمّر الدولة والمجتمع، نعم لمعايير ديموقراطية تضعها الأمم المتحدة وتفرضها على كلّ البلدان بلا استثناء» (مقابلة مع منى نعيم في جريدة «اللوموند». النص مترجم في جريدة «النور» التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري الموحّد، في عدد 12 آذار/ مارس 2003 بعنوان «مأزق المثقفين السوريين»). في تلك الفترة، كانت إقامة ميشال في الطائرات والفنادق أكثر من بيته في دمشق، وفعلاً هو أوّل مَن طرح فكرة «إعلان دمشق»، بعدما التقى المراقب العام لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في المغرب، في الشهر الخامس من عام 2005، وفي ظرف كان الضغط الأميركي فيه على السلطة السورية في أقصاه. ولكن أبو هشام لم يقتنع بفكرة «الإعلان»، إلّا بعد لقائه البيانوني في لندن، في تموز/ يوليو 2005، وكانت الفكرة إيجاد جسم سياسي معارض كبير يلاقي التغيير السوري المتوقع تحت الضغط الأميركي، كما جرى في بغداد ما بعد 9 نيسان/ أبريل 2003، وبيروت ما بعد 26 نيسان/ أبريل 2005. وفي «إعلان بيروت دمشق» (المنشور في «السفير» و«النهار»، في يوم 12 أيار/ مايو 2006)، ثمّة تشابه مدهش في النص مع نصّ قرار مجلس الأمن رقم 1680، الصادر بعد خمسة أيام، والذي أعدّه المندوب الأميركي جون بولتون، وكان ميشال هو العرّاب السوري للإعلان الذي كتبه الوزير مروان حمادة في مكتبه في جريدة «النهار»، وتمّ حمله «ديليفري» للتوقيع في دمشق.
في أثناء الانفجار السوري ما بعد 18 آذار/ مارس 2011، كان ميشال معتدلاً في البداية، وقد شارك في مؤتمر فندق «السمير آميس» الذي شارك فيه مثقّفون معارضون، وكان مرضيّاً عنه من السلطة. كما شارك في مؤتمر حلبون الذي عقدته «هيئة التنسيق»، في 17 أيلول/ سبتمبر 2011، وقدّمت فيه حلّاً تسووياً للأزمة السورية. عندما خرج من مطار دمشق في الشهر التالي، بدأ التطرّف عند ميشال يرتفع تدريجياً، حتى وصل إلى أقصاه عندما دخل في أيار/ مايو 2013 إلى «الائتلاف» ضمن عملية توسعة ذلك الجسم المعارض، والتي سعت إليها السعودية لتحجيم نفوذ الإسلاميين وقطر وتركيا. كان «الائتلاف» وقتها المظلّة السياسية للعسكرة، ويسعى إلى جلب التدخّل العسكري الخارجي، ولم تكن تفصل سوى أشهر عن تصريحات أطلقها معاذ الخطيب وجورج صبرة عن «جبهة النصرة كجزء من الثورة». خرج ميشال خائباً من تجربة «الائتلاف»، وفي سنواته الأخيرة تُلمس في مقالاته وتصريحاته خيبة منَ اصطدمٍ بحائطٍ كبير، ولكنّه لم يستفِد من ذلك ليقوم بمراجعة حقيقية لتجربة 2011 – 2021، وهو مثله مثل كثيرين من المعارضين عندما يقولون إنهم يقومون بمراجعة، ثمّ لا تلمس في نصوصهم أيّ مؤشر لها، بل كلاملالوجيا، كما كان يقول الياس مرقص (كان يلفظها كلاملالوجيا وكان يقول إنها تعني ما تعنيه tautologyأي حشو ولغو).
يبقى في القلب والعقل الكثير من المودّة والحب والاختلاف مع ميشال كيلو، في مزيج يتنازع قلبي وعقلي. ولكن يظلّ ميشال كيلو يكثّف في شخصه مزايا المعارضة السورية وعيوبها، خلال الأربعين عاماً الماضية.
* كاتب سوري
الاخبار
———————-
ميشيل كيلو.. أيها الطيب/ حسن منيمنة
“ميشيل كيلو حمل همّ سوريا ومحيطها المباشر والمجتمع الإنساني كله حيثما حلّ”
أن يكون الراحل قامة وطنية، وقومية (بأحلى المعاني)، وإنسانية، أمر بديهي لمن تلاقى دربه مع درب هذا المناضل، هذا المكافح، هذا المجاهد في سبيل الخير.
أن يكون صاحب رؤية ورؤيا بأن سوريا التي أحبها سوف تنجو من براثن الأذى اليومي، لتصل إلى بر أمان الحرية، كان عزاءً، كالشمعة في ليلة ظلماء، لمن شهد هذه الديار يتقاذفها جشع طغاتها وتخاذل من وسم نفسه بصداقتها.
ميشيل كيلو، حمل همّ سوريا ومحيطها المباشر والمجتمع الإنساني كله حيثما حلّ. كان ثابتاً في قناعاته، واضحاً في أفكاره، ساعياً على الدوام إلى إيجاد القواسم المشتركة دون تجاهل مواضع الاختلاف، ولكنه قبل كل هذا كان إنساناً طيباً، دون زعم ودون تكلف.
لحظات، أسجّلها له، ليس لأنها خارقة ومتميزة، بل لأنها اعتيادية، وفي اعتياديتها ملامح الطيبة التي لازمته.
في لقاء في مالطا عام ٢٠٠٤، جمع عدداً من المثقفين العرب، من مختلف الخلفيات الفكرية، بمجموعة من رجال الفكر الأميركيين المحسوبين في معظمهم على التوجهات المحافظة، كان ميشيل موضع إرباك لبعض المشاركين الأميركيين، ليس لخروجه عن التنميط الذي اعتمدوه ضمناً لنظرائهم العرب، اسماً وهوية، ولكن لمثابرته، بمطلق الرصانة والهدوء، على تثمين الفكر والتجربة الاشتراكيتين، بل الشيوعيتين، مع الإقرار بجسامة الأخطاء اللاصقة بهما، في أجواء فكرية كانت تعتبر أن أفلاسهما أمر محسوم.
لم يكن كلام ميشيل يشبه أقوال نوام تشومسكي أو غيره من الذين يصولون برفع اليسار وخفض اليمين، بل جاء مؤكداً على قناعات، قد تبدو بالية حين يتفوه بها غيره، حول فلسطين كدولة علمانية جامعة، والوحدة العربية بصيغة أقرب للاتحاد الأوروبي، وحول العدالة الاجتماعية شرقاً وغرباً. كان لا بد للمستمع لميشيل، سواء مباشرة بلغته العربية أو عبر الترجمة، أن يضع الاختلاف جانباً وأن يثابر على الإصغاء لكلام فصيح في بيانه صادق في معانيه.
على أن ما جعل حضور ميشيل هنا فصلاً راسخاً في ذاكرتي لم يكن أداؤه الفكري. بل هو أن أحد المشاركين الآخرين السوريين في اللقاء ألمّت به وعكة صحية قرابة منتصف الليل، وكان عليّ بالتأكيد، بوصفي أحد أصحاب الدعوة للّقاء، مصاحبته إلى المستشفى. ميشيل أصرّ على القدوم معنا، وشهدتُ عندها مدى العناية التي يوليها للزميل المريض، مواساةٌ أخوية حيناً أبوية أحياناً، لطف بالسلوك وتلطيف للمصاب، إلى أن اطمأن الزميل إلى استقرار حاله. ساعات أمضاها ميشيل في دور، تبين لي فيما بعد، أنه سمة دائمة من سمات سلوكه.
لقاء آخر جمعنا في إسطنبول، بعد أعوام على اندلاع الثورة السورية، وبعد أن فجعت هذه الثورة بتخاذل الأصدقاء المتعادين، وبتخاذل أصحاب المزاعم المتعاظمة حول استثنائية تقتصر على ما يبدو على تنميق الكلام.
يومها، كان ميشيل متألماً ألماً ظاهراً على وجهه، غير أنه، وإن اشتكى من غياب من وعد السوريين بالدعم، احتفظ خلف الألم بفرحة صادقة عبّر عنها حول المسار الأكثر تفاؤلاً والأسعد واقعاً في تونس. “تونس هي عزائي”، قالها ميشيل، في توسيع آخر لدائرة الأنا، لتشمل الآخر، فيصبح مصاب هذا الآخر مصابه، وفرحة هذا الآخر فرحته، بل لينتفي عن هذا الآخر أنه آخر.
حالة أخرى، وأخيرة للأسف، شهدتها من أخلاق ميشيل، كانت في باريس أواخر عام ٢٠١٩. احتضنت العاصمة الفرنسية يومئذ مؤتمراً حوارياً شهد العديد من النقاشات، المنتجة وخلافه. تعرّض في هذا المؤتمر أحد المشاركين لتهجّم على قدر من المبالغة في النقد من زميل يفوقه على ما يبدو بالمقام.
مرت شبه الحادثة هذه دون عواقب. غير أنه لم تفتنّي رؤية ميشيل، في أعقاب الجلسة، يتوجه إلى الزميل الذي تعرّض للنقد، ليثني على كلمته ويشكره على مشاركته. ميشيل على قدر مرتفع من الأدب واللطف، ولكنني لم أره يفعل ذلك في غير هذه الحالة، ولا هو أشار في كلامه إلى الزميل في الحادثة بعينها. أراد وحسب تلطيف الأمر له، دون إحراج أو إثارة.
لا تختلف كلماته الأخيرة في وصية نقلها الإعلام من حيث المضمون عن القيم التي عاشها ميشيل. هي في خلاصتها دعوة لتوسيع الذات، لتشمل ما يتعداها، وحين يعم الخير والسعادة بعض هذا الكل، يكون نصيب الذات منه حاضراً.
أراه فعَل. أراه مات سعيداً. طاب ذكرك أيها الطيب.
وجهك الباسم المتواضع يبقى شاهداً على الكرامة، على المبدأ. لم أسمعك تتبجح يوماً. زجّك جلادو الطاغية في سجن السوء، وخيّروك، يوم حان موعد خروجك وفق عدالتهم المشوّهة، بين أن توقّع ذليلاً خانعاً للطاغية، أو أن تبقى في زنزانتك إلى أجل غير مسمّى. اخترتَ أن تبقى في زنزانتك حراً، بدلاً من أن تخرج إلى عالمهم القبيح ملطخاً. وخرجتَ حين خرجت رغماً عن أنفهم، وأنت اليوم، وقد وافتك المنية، تريد لأهلك في سوريا أن يخرجوا بدورهم. سوف يفعلون، ولو بعد حين. وحين يفعلون تكون “سوريا هي عزاؤنا”.
الحرة
———————-
ميشيل كيلو الذي فسّر الحرية وسوريا وعجز عن عصفور/ عبدالله الموسى
لا ينتصر السياسي السوري بمعركة سياسية ضد أعداء الثورة لأنها معارك تفتقد لموازين القوة، وللسوري فيها هامش ناور فيه بعضهم بكل ما أوتي من مبادئ بحثاً عن النور والجدوى؛ وإنما ينتصر السياسي السوري بمحبة الناس له. هذه المعركة الأصعب في الحالة السورية، ولم ينل محبة الناس إلا قلة قليلة كالراحل الأستاذ ميشيل كيلو.
ربح ميشيل معركة الحب، ولم يصرعه المرض في أشده ليستسلم، فكتب الوصية وعايد السوريين برمضان ودعا ألا يكون في سوريا جائع. هي صوتية أخرى وأخيرة، لم تكن كسابقاتها عندما كان يحاول ميشيل كيلو تفسير سوريا وتحليل مركباتها وتفكيك معقداتها، كانت صوتية وداع وتهنئة رجل مسيحي للمسلمين، هكذا كان ميشيل كيلو يشبه سوريا.
استطاع ميشيل أن يكون القريب من هموم الناس، كل السوريين كانوا ينتظرون أحداً يفسر لهم وطنهم، ويطمئنهم بأن القادم خير، بث ميشيل المفقود في أرواح السوريين.. الأمل.. بثه في صوتيات يتداولها السوريون على هواتفهم في المخيمات على أمل العودة وفي المنافي على أمل العودة وفي أجساد المتعبين على الجبهات على أمل العودة وفي أرواح المستسلمين للواقع القهار على أمل العودة.. العودة لسوريا وللحلم الذي مات من أجله الشهداء مطمئنين بأن الشعلة لها حاملها وأن العيون لن تغمض وأن النفوس لن تستسلم، مطمئنين أن للشعلة جذوة والجذوة هي الأمل.
فسر ميشيل كيلو سوريا بدقة واستشرف للمستقبل مرارا وتكرارا، يدفعه إلى ذلك نوع من تأنيب الضمير لأنه فشل قبل سنوات كثيرة في تفسير معنى كلمة عصفور لطفل في المعتقل.
يكفي ميشيل كيلو تلك القصة التي رواها عن ابنة أحد الهاربين من النظام والتي ولدت ابناً في المعتقل، كان عمره 5 سنوات عندما أحضر السجان ميشيل كيلو ليروي له حكاية. لم يعرف الطفل العصفور ولا الشجرة، وفهم كيلو غاية السجان أنه كان يتحدى هذا المثقف المعارض في أن يروي قصة لطفل.
كان ميشيل كيلو يشبه سوريا أكثر، في كونه تحسن قليلا قبل أيام بعد عراك صعب مع كورونا في المنفى، وعاد فتراجعت صحته، وهذه حالة سوريا منذ سنوات، تتجاذبها صراعات الإقليم ومصالح اللاعبين فيتلقفونها عند الحاجة ويطردونها من بالهم دون ذلك، وتتقاذف الأمم شعبها المتناثر في كل الأصقاع، ويحارب من أجلها مَن تبقى بصرخاتهم وأظافرهم وبندقية وحيدة متروكة كادت تصدأ، ونفوس عزيزة.
وعندما دعا المصريون في أيلول من العام 2019 لمليونية في ميدان التحرير نشر الراحل تسجيلاً صوتياً تناقله الناشطون كما جرت العادة على تطبيق واتساب، قال فيه: “كل الكذب الذي تحدث عن نهاية الريبع العربي يتساقط اليوم.. لأن الربيع العربي فتح بلداننا على خيارات متنوعة وحرة بعد أن كان الخيار واحداً.. لا تصدق حدا داق طعم الحرية ولو لعشر أيام بضيعة نائية ومستعد يتنازل عنها”.
كانت فكرة الحرية بعظمتها وقدسيتها حاضرة بوضوح كبير لدى الأستاذ ميشيل، وفي فلكها كان الحديث يدور في الصوتيات والمؤتمرات وفي الأيام البيضاء والسوداء، ومنها انطلق في وصيته الأخيرة للسورين، قال” لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّكوا بها، في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخلّوا عنها أبدا، لأن فيها وحدها مصرع الاستبداد، فالحياة هي معنى للحرية، ولا معنى لحياةٍ بدون حرية. هذا أكثر شيء كان شعبنا وما زال يحتاج إليه، لاستعادة ذاته، وتأكيد هويته، وتحقيق معنى لكلمة المواطنة في وطننا..”.
وهذه وصية ثقيلة يتناولها شباب الثورة من جيل الثوار الأوائل الذين يتركوننا اليوم أيتاماً لا نعرف إلا معنى الحرية، دون مرشد يوجهنا إلى مستقبلها وتطبيقها وتحقيقها. هي وصية تعني أن مقارعة الاستبداد الأسدي لا يمكن بجيل أو اثنين، وأن المعركة طويلة وصعبة وأن النصر السوري وللأسف ليس صبر ساعة فقط، وأن الأمل سلاح المتروكين والمتعبين وأن المبادئ مصانة بدماء الشهداء وأرواح الراحلين.
رحل ميشيل كيلو، وفي رحيله تذكرة لأولي الثورة بأن قضيتهم تحتاج للكثيرين من أمثال ميشيل.. لا يستسلمون ويبثون الأمل ويسعون إليه بكل مستطاع.
———————-
ضريح ميشال كيلو وعرش بشّار الأسد/ فارس خشان
فيما “يتمرّن” بشّار الأسد على أداء دوره الهزلي، في المسرحية الانتخابية في سوريا، مات المعارض الرصين ميشال كيلو، في منفاه الباريسي.
ولن يتمكّن لا أهل ميشال كيلو ولا رفاقه ولا محبوه من نقل رفاته لترقد في أرض بذل من أجل عزّتها وازدهارها وتحرّرها كلّ سنوات حياته.
هذا المشهد على تراجيديته، ليس أكثر من مشهد عادي ومبتذل، في سيرة أيّ معارض للأنظمة المرعبة التي يتربّع النظام السوري على رأس قائمتها، لأنّه في ظلّها لا مكان إلّا لمن يلعق الحذاء الذي يدوسه ويخنقه ويذلّه ويحرمه ويجوّعه.
وهذا الحرمان حتى من ضريح في مسقط الرأس، يتباهى به لاعقو الأحذية، ويعتبرونه انتصاراً ويحتفلون به، ظنّاً منهم أنّ “سيّدهم”، بفعل ما يعرفونه عن ارتكاباته وجرائمه، هو التجسيد البشري لملاك الموت.
ولكن، ما يجهله هؤلاء أنّ أنظمة الموت لا يمكن أن تهبهم الحياة، بل الحريّة التي رفع لواءها ميشال كيلو، وارتضى من أجلها الملاحقة والإعتقال والتهديد والنفي.
وليس لهؤلاء سوى مساءلة يومياتهم عن حقيقتهم، فهل هم، فعلاً أحياء؟
لعلّ الجواب عن هذا السؤال يكمن في تشخيص وزير الخارجية الفرنسي للواقع السوري، إذْ إنّه، في الوقت الذي كان فيه ميشال كيلو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقف جان ايف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث وصف ما يُحكى عن انتصار النظام السوري بأنّه ليس أكثر من “خدعة بصرية”، وأشار الى أنّ المناطق التي يسيطر عليها النظام تعيش أسوأ حالات “الإفتراس الميليشياوي”، لافتاً الى أنّ الانتخابات الرئاسية التي يتهيّأ لها بشّار الأسد هي “كاذبة”، مجدّداً إصرار بلاده على معاقبته، أمام المحاكم الوطنية والدولية، بعد ثبوت إقدامه على ارتكاب هجومات بأسلحة كيمائية على الشعب، في أكثر من منطقة، وفي أكثر من مرحلة.
وما قاله لودريان يقول مثله، وبحدّة أكبر وبتعابير أعنف، المعنيون على امتداد الكرة الأرضية، بما في ذلك مفكرون وصحافيون روس موالون للرئيس فلاديمير بوتين الذي يحمي بقدراته العسكرية والدبلوماسية نظام التجويع والجريمة والإستقواء والإبادة.
في ظلّ هذه التوصيفات للنظام السوري الذي تهرب منه غالبية الشعب، لجوءاً ونزوحاً وانفصالاً وهجرة، ترتقي إلى مراتب متقدّمة قصة حياة ميشال كيلو، فيما ينحدر النظام الذي يزعم أنّه “منتصر”، الى آخر مدارك الجحيم.
إنّ النظام السوري، عندما حرص على مطاردة ميشال كيلو وأمثاله ودفعهم الى المنافي، إنّما حوّل نفسه الى جثّة لا تجد من يدفنها، في حين كان يمكنه، لو التفت الى لواء الحرية الذي رفعه كيلو وأمثاله، برصانة وسلمية وقانونية ورقي، أن يكون حيّاً يَرزق سوريا وشعبها الحياة.
لكنّ هذا النظام فضّل على رافعي لواء الحياة حاملي بنادق القتل وتنظيم “داعش” وشقيقاته، والترسانة الروسية ومرتزقة “الحرس الثوري الإيراني”.
وبدل أن يأخذ المحيطون بسوريا العبرة من نتائج أداء بشّار الأسد، إقتدوا به. وهذه حال هؤلاء الذي يتحكّمون بلبنان ويحكمونه، فهم يفضّلون أن يكونوا جثثاً مهترئة في مناصبهم، على أن يكونوا جزءاً من رافعي لواء الحرية المنجِبة للحياة.
وليس عبثاً أنّ بعض ما يقال في بشّار الأسد، على المنابر السياسية والدبلوماسية والإعلامية، يقال أيضاً في هؤلاء الذين يقتدون به، في بلدانهم.
لقد مات ميشال كيلو حرّاً، وكان هدفه أن يتمكّن، يوماً، من أن يمنح، من خلال نضالاته المرّة، شعبه الحياة، في حين أنّ حارميه من ضريح في وطنه، يترنّحون جثثاً متحرّكة، في قصورهم، موزّعين الموت والفقر والجوع والحرمان، على كل من تجبرهم أقدارهم على أن يكونوا تحت سيطرتهم.
الحاضر يُعطي لمحة عن المستقبل. هو يؤكّد أنّ النظام الذي اضطهد ميشال كيلو، يترنّح ملعوناً وسيموت ملعوناً وسيدخل كتب التاريخ ملعوناً.
النهار العربي
———————————
في رحيل ميشيل كيلو/ محمد كريشان
لم أكن سمعت به من قبل، ولكن حين التقيته لأول مرة في إحدى مقاهي دمشق وقد جاء صحبة صديقينا علي العبد الله دخل إلى قلبي بسرعة. كان ذلك عام 1997، فوجئت وقتها بأن ميشيل كيلو يتحدث عن الوضع الداخلي في سوريا بجرأة لافتة غير عابئ بمن يجلس بجانبنا وهو يعلم، أكثر من غيره، أن من بينهم عيونا كثيرة للمخابرات.
لهذا لم أستغرب أن صار هذا الذي جلست معه جلسة تعارف قصيرة على فنجان قهوة أحد المساهمين بقوة وهمة في ما عرف بـ«ربيع دمشق» القصير عام 2000 حين انطلقت المنتديات والندوات تتحدث عن الوضع الداخلي في سوريا ومطالب الاصلاح الضرورية بعد رحيل حافظ الأسد وتسلم ولده بشار زمام الأمور. ولهذا لم أستغرب كذلك أن صار هذا الرجل عام 2005، أحد الموقعين البارزين مع عدد من الشخصيات والتيارات على «إعلان دمشق» تلك الوثيقة السياسية التي قدمت تصورا محددا للانتقال الديمقراطي في البلاد، كما كان من الموقعين على «إعلان بيروت – دمشق» في 2006، وهو العام الذي اعتقل فيه مع آخرين، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية».
في يوليو/تموز 2008، كنت في باريس أحاور في مقابلة تلفزيونية الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان يزور فرنسا وقتها. كان ميشيل كيلو وقتها في السجن، لهذا ظللت ألح وأعيد على الرئيس لأظفر منه بكلمة طيبة أو أي وعد غائم باطلاق سراحه ورفاقه الآخرين دون فائدة. واصلت الالحاح والتكرار بأن هؤلاء المسجونين من «المعارضة الوطنية» حتى ضمن التصنيف الرسمي، لكنه ظل يتهرب ويراوغ ويعيد بأن هؤلاء لم يسجنوا لآرائهم بل لخرقهم القانون السوري!! كان عنيدا ولم يشأ أن يقدم أي تنازل أو استعداد للنظر في وضعهم وهو ذات العناد الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه الآن.
عندما اندلعت الثورة السورية مطالبة بالحرية والكرامة كان طبيعيا جدا أن يكون ميشيل كيلو أحد أبرز وجوهها وظل محافظا إلى آخر يوم في حياته على نوع من «النقاء» لم يكن موجودا للأسف عند كثيرين. ووفق ما ذكرته السيدة سميرة المسالمة الصحافية السورية التي وقفت مع الثورة مبكرا وقد كانت رئيسة تحرير «تشرين» فإن ميشيل كيلو، الذي توفي الاثنين في باريس، طلب منها اعداد وجمع رسائله التي كتبها في مقال واحد وارسالها للصحافي معن البياري لينشرها في جريدة «العربي الجديد» لتكون «وصيته إلى كل السوريين بكل قومياتهم وإثنياتهم، متمنياً لهم وطنا حرا كافح من أجله مع كثير من السوريين الأحرار، ودفع أثماناً باهظة لموقفه الحر والنبيل».
نشرت هذه الوصية فعلا وانتشرت على نطاق واسع، قبل وفاته وبعدها بالخصوص، ففيها عبّر الراحل عن كل ما استخلصه من دروس، ليس فقط من تجربته النضالية قبل الثورة وإنما كذلك بعدها، في ضوء ما عرفته من دماء وانكسار بعد مئات الآلاف من الشهداء والجرحى واللاجئين والنازحين. أفقه الرحب وقبوله بالاختلاف ونبذه للإقصاء هو ما جعله يقول للسوريين في هذه الوصايا «ألا ينظروا إلى مصالحهم الخاصة كمتعارضة مع المصلحة العامة، وألا ينظروا الى وطنهم من خلال أهدافهم وإيديولوجياتهم، بل من خلال وطنهم» حاثا الجميع على الالتقاء «بمن هو مختلف معكم بعد أن كانت انحيازاتكم تجعل منه عدواً لكم». قائلا لهم إنهم لن «يقهروا الاستبداد منفردين، وإذا لم تتحدوا في إطار وطني وعلى كلمة سواء ونهائية، فإنه سيذلكم الى زمن طويل جدا» و أنكم «لن تصبحوا شعباً واحداً ما دمتم تعتمدون معايير غير وطنية وثأرية في النظر الى بعضكم وأنفسكم، وهذا يعني أنكم ستبقون ألعوبة بيد الأسد الذي يغذي هذه المعايير وعلاقاتها وأنتم تعتقدون انكم تقارعونه».
لكل ما سبق رثاه الجميع، وحزن عليه الجميع، من السوريين ومن غيرهم من التواقين إلى الحرية. الكل كتب عنه برومانسية واضحة وبكثير من الود لهذا السياسي المفكر الذي ظل محل تقدير واحترام الجميع تقريبا. حتى الأحزاب خرجت بياناتها بلغة غير التي تلك الركيكة المعهودة في بيانات الأحزاب، كهذا المقطع الجميل مما ورد في بيان «حزب الشعب الديمقراطي السوري» اليساري المعارض:
لو صارت البلاد بلادنا…
لمشت دمشق في جنازتك، ولقُرعت أجراس الكنائس في باب توما حداداً عليك.
لو صارت البلاد بلادنا…
لبكتك حمص وحماة ومصياف وعفرين ووادي العيون جهاراً.
لو صارت البلاد لأصحابها…
لشدوا عليك بدير الزور معادةً في الساحة العامة، ولنصبت لك في المدن السورية خيم العزاء، ولارتفع صوت القرّاء يتلون آياتٍ من الذكر الحكيم وسورة ياسين.
ويوماً ما، إن لم نكن نحن… فسنوصي أبناءنا
حين يتحقق حلمك بسوريا الحرة والديمقراطية، المتصالحة مع نفسها، الململمة لجراحها.
سنوصي أبناءنا إن لم نكن نحن…
أن يقفوا على قبرك ليقرؤوا الفاتحة وإصحاحاً من الإنجيل.
القدس العربي
—————————–
“ناهض الأسدين في نصف قرن”.. حكاية السوري ميشيل كيلو بلسان من رافقه/ ميشيل كيلو
تُوفي المعارض والمفكر السوري، ميشيل كيلو. وبعد هذا الخبر لم يعد هناك من شخص يشبهه ويستمع لهموم السوريين المعارضين ويسألهم عن أحوالهم، أو حتى يبث الطمأنينة والأمل بأروحهم، ولو كان ذلك “عن بعد”.
هو سلوكٌ وحال قلما يرتبط بسياسي بارز تصدر مشهد الملف السوري، سواء ما قبل أحداث الثورة السورية في عام 2011 أو بعدها، وصولا إلى الحقبة الحالية.
اعتاد كيلو في السنوات العشر الماضية على مشاركة السوريين في أحاديثهم، وبشكل أساسي عبر “تطبيق واتساب”، لتنشط تسجيلاته الصوتية على نطاق واسع، منها الموجه لملايين السوريين في شمال غرب البلاد، وأخرى استشرف فيها مستقبل سوريا، مؤكدا على أمل إسقاط النظام الاستبدادي، ولو طال الأمر لسنوات.
قبل وفاته بأسبوع كان لافتا تلك الوصية التي كتبها للشعب السوري بعنوان: “كي لا تبقوا ضائعين في بحر الظلمات”، وفي كل كلمة منها كان يدرك كيلو أن ما عانى منه السوريون خلال عقود حكم الأسد الأب والابن لن يبقى دون نهاية، داعيا إلى “الوحدة من أجل الخلاص” “فالحرية ثمنها كبير”.
ليس كغيره من باقي الشخصيات السياسية السورية، التي عرفها السوريون في العقد المنصرم، فقد كان لكيلو السياسي والمفكر في آن معا حيزا فريدا من نوعه، لاسيما أنه يحسب على فئة “المحاربين القدامى لنظام الأسد”.
إذ لم يكن نشاطه السياسي مقتصرا على حقبة الأسد الابن، بل تعود جذوره إلى عهد حافظ الأسد الأب.
“نصف قرن ضد نظام الأسد”
81 عاما قضى ميشيل كيلو أكثر من نصفها في معارضة نظام الأسد ورفض سياسته الاستبدادية في سوريا، الأمر الذي جعله أمام خطر القمع والاعتقال. بداية في سبعينيات القرن الماضي، وحتى في الثمانينات والتسعينيات، ومن ثم بعد وفاة حافظ الأسد وتسلم ابنه، وما تبع ذلك من “ربيع دمشق” و”إعلان دمشق”.
ومنذ تلك الفترة كان لكيلو مساهمات سياسية شتّى، وإلى جانبها سلك مسار آخر، وقدم من خلاله مساهمات فكرية وأدبية وروائية، بالإضافة إلى مساهمات في الترجمة، حتى أنه ترجم كتبا بارزة، من بينها “نظرية الدولة” و”الوعي السياسي والاجتماعي”.
وُلد كيلو من عائلة مسيحية في مدينة اللاذقية عام 1940، وعاش طفولته في رعاية والده الذي عرف عنه سعة ثقافته.
وتعرض للاعتقال في سبعينيات القرن الماضي لعدة أشهر ثم سافر إلى فرنسا، ثم عاد إلى دمشق واعتقله النظام السوري مرة ثانية عام 2006، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي”، وأُفرج عنه عام 2009.
بعد انطلاقة الثورة السورية كان من أوائل المعارضين القدماء المناهضين لنظام الأسد، ليشارك في العمل على توحيد أطياف المعارضة السورية “حديثة العهد” مع مجموعة من أصدقائه السابقين والمثقفين.
وحين فشلت جهودهم وتأسست “هيئة التنسيق الوطنية”، لم ينتسب إليها، وشارك عام 2012 في “تأسيس المنبر الديمقراطي”، وفي نهاية شهر سبتمبر 2013 أسهم في تأسيس “اتحاد الديمقراطيين السوريين”.
كما أنه كان عضوا بارزا في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” قبل أن يغادره عام 2016، نتيجة خلافات.
“ظل يحلم بسوريا مستقلة”
بعد انسحابه من “الائتلاف السوري” تفرغ كيلو للكتابة في صحف عربية، حيث أقام في منفاه بالعاصمة الفرنسية باريس، فضلا عن مشاركات تلفزيونية له على محطات عربية أيضا وأخرى أجنبية، قدم فيها تحليلات سياسية عما وصلت إليه سوريا بعد عشر سنوات من الحرب.
وفي كل إطلالة لكيلو لم يقطع تعبيره عن الأمل في قرب الخلاص من النظام الاستبدادي في البلاد، في موقف لم يغيره، على الرغم من العقود “القاسية” التي عايشها، والانكسارات المتتالية التي تعرض لها في بداية شبابه وحتى وصوله لعمر الثمانين.
وعقب ذيع خبر وفاته تتالت نعوى السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعوا في كتاباتهم على أن “كيلو هو رجل الكلمة الصادقة”، لاسيما أنه ثبت على رسالته في السجون والشراد الطويل، وظل يحلم بسوريا “حرة مستقلة حتى لقى الله”.
وقد يكون هذا الإجماع على نعيه، حسب أصدقاء له تحدث إليهم موقع “الحرة” كونه كان شخصية مقربة من الشارع في سوريا، على عكس باقي السياسيين، الذين “يجلسون في القصور”، بمعنى اصطلاحي.
أيضا كان كيلو قد امتاز من بين أقرانه السياسيين بأنه حاضر في المشهد على الدوام، ولا يستطيع أحد أن يمر على تاريخ الحركة السياسية في سوريا منذ الستينيات، من دون أن تستوقفه تجربة هذا الرجل.
“لا غنى عنه لأي مشروع وطني”
المعارض السياسي السوري، سمير نشار تعود معرفته بميشيل كيلو منذ بداية “ربيع دمشق” عام 2011، في أثناء تشكيل “لجان إحياء المجتمع المدني”.
يقول نشار في تصريحات لموقع “الحرة”: “الراحل الأستاذ ميشيل كيلو قامة وطنية بارزة في الوسط العمل السياسي المعارض، منذ ما يقارب الخميس عاما”.
ويتابع: “اليوم تخسر المعارضة السورية أحد أبرز أعمدتها المعروفة على الصعيد الوطني والإقليمي، وصاحب المبادرات الوطنية الخلاقة والأفكار الرائدة في إيجاد الحلول السياسية من المآزق التي تعرضت لها المعارضة السورية خاصة بالداخل السوري قبل الثورة”.
كان لكيلو دورا قياديا في توجيه “بوصلة العمل الوطني”.
واعتبر نشار أن الراحل “لا غنى عنه لأي مشروع سياسي وطني معارض لنظام الأسد الأب والأسد الابن، حيث كان هناك هامش ضيق من حرية الحراك السياسي للعمل المعارض، منذ وراثة بشار الأسد للنظام والسلطة في سورية منتصف عام 2000 “.
ما الذي تميز به؟
عن هذا السؤال أجاب الصديق القديم لكيلو المعارض السوري، جورج صبرا.
ويقول صبرا الذي كان آخر لقاء بينهما في عام 2019: “المرحوم كان نموذج للمثقف العضوي ابن الشعب الحقيقي وابن الطبقات الاجتماعية المكافحة من أجل حياة أفضل، وابن الثقافة الديمقراطية التي تسعى من أجل بناء وطن حقيقي يتسع لجميع أبنائه، من مختلف المكونات القومية والدينية والطائفية”.
ميشيل كيلو توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في فرنسا وكتب وصيته للشعب السوري قبل أن يرحل
كتبها قبل وفاته.. وصية ميشيل كيلو للسوريين: ستدفعون ثمنا كبيرا لحريتكم
قبل وفاته بأسبوع كتب المعارض السوري، ميشيل كيلو، وصية وجهها للشعب السوري، أثناء خضوعه للعلاج من فيروس “كورونا” في إحدى مشافي العاصمة الفرنسية باريس.
ويشير صبرا في تصريحات لموقع “الحرة”: “هذا النوع من الثقافة جعل من ميشيل كيلو يسبح في بحرين، الأول في بحر الثقافة السياسية والاجتماعية والأكاديمية ويكتب فيها ويؤلف، أما الثاني فهو بحر السياسة اليومية، التي تسعى من أجل التغير في حياة البلاد لمصلحة الطبقات الاجتماعية، وكذلك من أجل العقل الوطني”.
بدوره يوضح المعارض السياسي، سمير نشار أن الراحل ميشيل كيلو تمايز عن أقرانه من المعارضين بـ”الكاريزما الشخصية والحضور اللافت”.
ويتابع: “كما لا يمكن لي عدم ذكر مبادراته السياسية الجريئة والأفكار التي أنتجت حالات سياسية معارضة حاولت تعبئة الفراغ، نتيجة التصحر السياسي، الذي أصاب الحياة السياسية والعمل السياسي منذ انقلاب عام 1970 الذي أوصل حافظ الأسد للسلطة”.
خارج المشهد بعد “الخلل البنيوي”
بالعودة إلى المحطة الأخيرة التي كانت لكيلو ضمن أجسام المعارضة، وهي “الائتلاف الوطني السوري”، فلم تعرف الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب منه حتى الآن، في ظل حديث متكرر عن خلافات داخلية، وباتت مؤخرا روتينا شبه اعتيادي.
في المقابل يشير المعارض، سمير نشار إلى أن ابتعاد كيلو عن مؤسسات المعارضة السياسية لعدة سنوات يعود لـ”نتيجة اقتناعه أن هناك خللا بنيويا في تأسيس تلك الأجسام”.
ويوضح نشار: “نشأ الخلل عن وصاية الدول الإقليمية على تلك الأجسام، وفقدانها للقرار الوطني السوري، الذي يعبر عن مصلحة السوريين والثورة السورية أولا، كما فعل الكثيرون من المعارضين المخضرمين الذين غادرو تلك الأجسام، بعد أن شعروا أن وجودهم ضمنها لم يعد مفيدا في تقويم اعوجاجها، وإصلاحها لخدمة مجتمع قوى المعارضة والثورة”.
وتحدث نشار المقيم في إسطنبول عن أبرز مساهمات الراحل، بينها أنه كان وراء “مبادرة لجان إحياء المجتمع” خلال مرحلة “ربيع دمشق”.
وأيضا هو من ساهم في إنضاج فكرة “إعلان دمشق”، الذي انبثق عنها تحالف قوى وشخصيات وأحزاب وتيارات يسارية وقومية وإسلامية وليبرالية للتغير الوطني الديموقراطي في سوريا.
وإلى جانب ما سبق ساهم كيلو بشكل رئيسي مع عدد من المثقفين اللبنانيين في إنتاج بيان بيروت-دمشق، دمشق – بيروت، الذي أدى لاعتقاله لمدة ثلاث سنوات في سجون الأسد.
“مثقف عضوي سوري”
من كتابات كيلو سلسلة “قصص واقعية من عالم الأشباح.. ذكريات من سجون الأسد”، والتي كشف فيها تفاصيل حياة أليمة عاش السوريون فظاعاتها طوال عقود خمسة في عهد الأسدين.
وله أيضا قرابة أربعين كتابا مترجما عن الألمانية، التي يتقنها، في الفكر والفلسفة والاقتصاد والتاريخ.
يصفه صديقه القديم، جورج صبرا بأنه “المثقف العضوي السوري، الذي ثبت اسمه في إطار الثقافة السورية والأكاديمية، وفي الوقت نفسه في إطار السياسة الوطنية اليومية للسوريين”.
واعتبر صبرا أن “كيلو كان حالة تشكل مصدر غنى للحياة العامة السورية، وكان له الفضل في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني خلال ربيع دمشق وأثناء الحراك الشعبي في تلك المرحلة”.
وعن فقدانه في الفترة الحالية يشير صبرا إلى أن ذلك “خسارة كبيرة لإيقاع العمل الوطني بوجهيه التثقيفي والسياسي، لأن كيلو كان منخرط بفعالية في كل النشاطات التي لها علاقة بالثورة، وممتدة على طول البلاد وعرضها”.
ويتابع: “سنبقى نحن العاملين في الحقل العام نفتقد لقلم ميشيل كيلو أسبوعيا، ولشخصيته الموجودة معنا في اللقاءات والغرف، وفي مشاريع البناء الوطني المستمر والمتعدد الأشكال، كذلك في إطار المشاريع العربية”.
ضياء عودة – إسطنبول
————————–
خطايا العاشق ميشيل كيلو*/ عدنان عبد الرزاق
تمنيت على قادة المعارضة السورية، تنكيس أعلام الثورة، وتواصلت مع بعض أصحاب القرار ليفعلوا، أو يعلنوا الحداد ثلاثاً على الأقل، على قامة وطنية من عيار، مناضل قلما يتكرر، لكني منيت بالخيبة كما أكدوا المؤكد، بأنهم أقل سياسة من التقاط هكذا لحظات.
وخشيتُ، ليس لخشيتي من مبرر، أن يُشير أحد الساسة من حول بشار الأسد عليه، فينعي ميشيل كيلو كقامة ثقافية ومفكر وطني، فيتبدل فكر الحملة الانتخابية، من توزيع البرغل إلى وعي ودهاء سياسي، إذ يمكن فيما لو سار عليه النظام، أن يوصله لفترة وراثية رابعة، بأكثر جماهيرية على الأقل، إن انبرى قارئ للقول: واصلها واصلها.
المهم، ألّف المناضل ميشيل كيلو بوفاته أول من أمس، بين جلّ السوريين، وأكد من جديد لكل من يتصّيد بمياه الطائفية، أن السوريين أبعد ما يكونوا عن مسيحي ومسلم أو حتى عن سني وعلوي، إن كانت الوطنية ومصير البلاد بالكفة الأخرى، وزاد السوريون من تأكيد الإخلاص لمن يستأهل الوفاء.
وذلك، رغم ما نبشه الحب العام لفقيد سوريا الكبير، من بعض الأحقاد والغيّرة، حتى بدواخل من لبسوا ثوب الحرية والنضال مقلوباً، فقرأنا وسمعنا بعض “الخيبات” التي وصلت حدود الاتهام وتلوّث يد كيلو بالدماء، لأنه شارك بمؤسسات المعارضة وتماشى مع تكتلات إقليمية فرضها القرار الدولي وسيرورة المخطط، قبل أن يكسو “كيلو” الإحباط جراء النكران من جلّ من تربوا على معارفه ونضاله وبعد اتضاح حجم المخطط الدولي لسوريا والحؤول، ولو بالدم، دون الوصول لحرية الشعب وديمقراطية الدولة، لينسحب من أي تمثيل رسمي ويتفرّغ للكتابة ومشاركة السوريين، كل السوريين، رؤاه وهواجسه وأحلامه، ولو عبر إطلالات إعلامية أو رسائل “الواتس أب” التي أوصلت تحليلات “كيلو” إلى جلّ بيوت السوريين.
بل وآثر التصاقه بالشعب حتى قبيل وفاته بأيام، فأرسل بخط يده إلى السوريين “كي لا تبقوا ضائعين في بحر الظلمات”، موصياً بلاءات عدة “لا تنظروا إلى مصالحكم الخاصة كمتعارضة مع المصلحة العامة، فهي جزء أو يجب أن تكون جزءا منها” و “لا تنظروا إلى وطنكم من خلال أهدافكم وإيديولوجياتكم، بل انظروا إليهما من خلال وطنكم، والتقوا بمن هو مختلف معكم بعد أن كانت انحيازاتكم تجعل منه عدوا لكم” ولا تفرقوا “ففي وحدتكم خلاصكم، فتدبروا أمرها بأي ثمن وأية تضحيات، فلن تصبحوا شعبا واحدا ما دمتم تعتمدون معايير غير وطنية وثأرية في النظر إلى بعضكم وأنفسكم، وهذا يعني أنكم ستبقون ألعوبة بيد الأسد، الذي يغذي هذه المعايير وعلاقاتهم، وأنتم تعتقدون بأنكم تقاومونه”.
خاتماً لاءاته “لا تتخلوا عن أهل المعرفة والفكر والموقف، ولديكم منهم كنز.. استمعوا إليهم، وخذوا بما يقترحونه، ولا تستخفوا بفكر مجرّب، هم أهل الحل والعقد بينكم، فأطيعوهم واحترموا مقامهم الرفيع”.
بل وزاد الراحل الذي كان يتفاخر ويكرر أنه ابن الثقافة الإسلامية كما المسيحية، بمباركة للسوريين بحلول شهر الصوم، بصوت مخنوق من وراء كمامة الأوكسجين، لتكون آخر ما يتركه “ميشيل كيلو” بصوته، قبل أن يرحل عن 81 عاماً، قضى أكثر من نصفها بين الاعتقال والملاحقة والمنافي…وجميعها بالحلم للوصول للحرية التي آثر اعتبارها، الغاية الأولى والنهائية للإنسان.
قصارى القول: سريعاً رغم أننا على الأرجح، لن نضيف إلى معارف السوريين إن قلنا، أن “كيلو” ترجم عشرات الكتب عن الألمانية وتنوعت مؤلفاته بين الفكر والسياسة والقصة والرواية، كما ليس من جديد بالإشارة، لتاريخه النضالي الحافل، مذ رمى بالتاسع من تشرين الأول عام 1979 حجره بمياه مخطط حافظ الأسد الآسن، وقت نصب للسوريين شرك “تطوير الجبهة الوطنية التقدمية” والتقى وفدها مع الصحافيين والمثقفين لسبع ساعات، كان لطرح “ميشيل كيلو” و”عادل محمود” خاصة، أسباب تفشيل التآمر، بل وليس من المبالغة القول، إن لطرح “كيلو” وآخرين وقتذاك، السبب بحراك شعبي ونقابي ثوري، كشف نوايا الأسد الأب، فعجّل بمخططه القمعي ليطاول “كيلو”، كما كثيرين غيره، الاعتقال.
ومما قاله “كيلو” بذلك اللقاء “المطلوب إسقاط منجزات الشعب السوري، وهذا ممكن بضرب الحريات، وبضرب الديمقراطية…. الأزمة التي نعيشها مميتة. لا دور للشعب، والحريات خنقت عن سابق تصور وتصميم…العيب الأساسي هو في بنية البلد، وفي القوى، وقد جررنا إلى هذا العيب تحت شعارات التقدم. وعي الشعب مسألة هامة، وقد وصل إلى مرحلة خطيرة من التدمير. المهم إصلاح جذري، وليس معالجة ظواهر خارجية وأخرى داخلية.
وختم “كيلو”: “إذا لم نكن قد حللنا مسألة الخبز، فمتى تـُـحلُّ القضايا الأخرى”.
لكن الراحل “كيلو”، لم يثنه السجن عن حلمه التنويري والديمقراطي، ولو عبر الصحافة التي درسها بمصر وألمانيا، فأوجع الأسد الأب بمقالات وافتتاحيات سجلها له تاريخ الثمانينات والتسعينات، قبل أن يعود نهائياً إلى سورية، ليشتغل على الأرض، سواء عبر المنتديات “الحوار الوطني”، “جمال الأتاسي” قبل أن يتفتح ياسمين “ربيع دمشق” بالتوازي مع مرحلة توريث بشار الأسد وفخ بالون الحريات الذي رماه ابن أبيه وقتذاك.
ليكون في “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” في أكتوبر عام 2005 والدعوة، لأول مرة من داخل سورية، إلى نظام ديمقراطي ومن ثم “دمشق بيروت- بيروت دمشق” في مايو 2006 الذي طالب خلاله 500 ناشط من البلدين، بتصويب العلاقة مع لبنان واحترام استقلاله وسيادته، مبرراً لبشار الأسد لسجن “كيلو” مجددا، رغم أن الراحل أكد عبر مقال وهو من داخل السجن، أن سجنه لا يتعلق ببيان دمشق بيروت، وربما بسبب مقالته “نعوات سورية” التي نشرت على ما أذكر بالشهر نفسه.
“واليوم، وبعد سبعة أشهر على وجودي في السجن، أراني أتساءل: هل صحيح أنه تم توقيفي بسبب إعلان دمشق بيروت، لا، ليس إعلان بيروت/دمشق سبب اعتقالي. هذه قناعتي… وإذا كان هناك من يريد الانتقام مني…؛ فإنني أتفهم موقفه وإن لم أقبله، مع رجاء أوجهه إليه هو أن يمتنع عن وضعه تحت حيثية القانون والقضاء، كي لا يقوض القليل الذي بقي لهما من مكانة ودور”.
ليأتي نضال “كيلو” المعروف، خلال الثورة ومذ انطلاقتها، سواء بالعمل الميداني أو التنظيري والتنظيمي “المنبر الديمقراطي، اتحاد الديمقراطيين السوريين ومن ثم الائتلاف” حتى انسحابه عام 2016.
ولكن، هل ناضل “ميشيل كيلو” لنحو نصف قرن، بعصمة ومن دون أخطاء، على الأقل، بعد أن نال السوريون بعض حريتهم بعد الثورة وتسلطت أضواء الإعلام، على كل فعل وتصريح وزيارة؟.
بعيداً عن فلسفة “الخطأ” سواء وفق الرؤى المختلفة أو المعايير الذي يأتي الممكن والمرحلة بمقدمتها، أو حتى تعدد زوايا رؤية المصلحة الوطنية.
أأخطأ “ميشيل كيلو” باعتباره جبهة النصرة فصيلاً ثورياً؟ بل ومحاولته الوصول إلى أمير الجبهة في القلمون “أبو مالك الشامي”، أو على الأقل، هل وقع بفخ العامة، وهو السياسي والمفكر، باعتبار مد اليد للنصرة خطوة على طريق إسقاط الأسد، وبعدها يتم تصويب الهنات، متجاهلاً ذهنية وأهداف الراديكاليين؟!
أأخطأ “ميشيل كيلو”، بوضع يده، خلال التنظيمات السياسية المعارضة، بيد مراهقين ونفعيين، أم تراه كما قال مرة، يحاول ضبطهم، كما أن لهم الحق بسوريا؟!
هل أخطأ ميشيل كيلو بكثرة تصريحاته وإيثاره ضخ الأمل، حتى بأكثر اللحظات سوداوية وإحباطاً، أم من أهم صفات الثائر، استمرار الأمل وإغلاق أبواب الإحباط عن الشعوب؟!
وهل أخطأ أبو أيهم بمشاركته اللجان والمؤتمرات والمنتديات، حتى مجموعات لا حصر لها على الواتس أب، في حين أن دوره بمكان آخر، حيث لا يمكن لكثيرين الوصول إليه أو ملأه؟!
نهاية القول: طبيعي أن يخطئ “ميشيل كيلو”، وذلك ليس فقط، بسبب تعدد مستويات الحالة السورية، بعد الأسلمة والتدويل والتسليح والتدخلات، بحيث يستحال على محلل أو مفكر، التنبؤ إلى أين المآل، بل أيضاً، لأن “كيلو” نزل إلى أرض السياسة، ليقود ويناضل ويجرّب، ولم يهرب كما كثيرين، إلى أبراج التنظير عن بعد أو السعي للجوء والجنسية والمنافع.
وأخطأ أيضاً، لأن كل ما فعله، كان بدافع عشقه لسوريا وإيماناً بوصولها للحلم والمشتهى، فميشيل كيلو ولمن يعرفه عن قرب، هو طيب بطبيعته وشعبي وابن بلد بمنشئه ومتواضع جراء سعة علمه وزهده واتساع تجربته، وهذه الصفات عادة ما تتنافى مع طبائع ممتهني السياسة، إن لم نقل مقتلهم.
لكن غير الطبيعي، أن يحاول البعض تصيّد تلك الأخطاء والتنكر لخمسين سنة من النضال المستمر، ربّعت “ميشيل كيلو” على قمة المثقف العضوي والمناضل الشعبي والمفكر الموسوعي…وألا يكسو سوريا السواد، على قامة، كل الأماني ألا تنشف أرحام النساء وتلد كمثلها.
—————————
رحيل فارس المعارضة ميشيل كيلو/ رامي الشاعر
رحل عن عالمنا، صباح 19 أبريل الجاري، فارس نبيل ومناضل صنديد في خندق المعارضة السورية النزيهة، الصديق الوفي، ميشيل كيلو. لكنه أبى أن يرحل دون أن يترك لي كنزاً ثميناً، أرسله لي عبر تطبيق “واتساب” قبل أسابيع قليلة من رحيله.. تسجيل بصوته يشرح لي فيه باختصار شديد مشوار معارضته لطبيعة وشكل الحكم للرئيسين حافظ وبشار الأسد، والتي لجأ فيها إلى شتى السبل والوسائل السياسية السلمية المشروعة، وعبّر عن معارضته بكل صراحة وجرأة، وقوبل على الرغم من ذلك بالسجن وتشويه السمعة ونهاية بالنفي، حتى وافته المنية في المهجر. المعارضة
حينما تستمع لكلمات ميشيل كيلو الرصينة، وأفكاره النيّرة النبيلة، يعتريك الأسى لما وصلنا إليه في أوطاننا من حوار الطرشان. وقد بدأ كيلو طريقه مع حافظ الأسد منذ 42 عاماً، مناضلاً ومعارضاً شريفاً لسياسات الأسد.
وفي أبريل من العام 2011، حينما بدأت أحداث درعا، واندلعت المظاهرات، وبناء على وساطات وتدخلات من الأصدقاء، وبطلب من القصر الجمهوري، دخل ميشيل كيلو إلى القصر بصحبة أرملة صديقه، سعد ونوس، الفنانة فايزة شاويش، ليجتمع لمدة ساعة ونصف بمستشارة الرئيس بشار الأسد، السيدة بثينة شعبان. المعارضة
يتابع صديقي الراحل، ميشيل كيلو: لقد قلت لها آنذاك أننا لم نترك وسيلة إلا وطرقناها، وقد تقدمت بورقة عام 2005، حينما قررنا كلجان مجتمع مدني إبداء حسن النوايا تجاه النظام الجديد، وحضرنا اجتماعاً للجنة الحريات والديمقراطية التحضيرية بالمؤتمر، بدعوة من القيادة القطرية، وكنا 6 أشخاص.
يقول ميشيل كيلو في تسجيله الأخير الذي أحظى الآن بشرف صياغته: “لقد رفعت تلك الورقة إلى الرئيس، وهي تقترح فتح حوارٍ حول قضايا الشباب والعمل وتوزيع الدخل القومي. لنتفق في هذا الحوار على حلول، نعترف خلالها بشرعية النظام، مقابل أن يعترف هو الآخر بشرعية المعارضة، فنحذف نحن شعار إسقاطه، ويتوقف هو عن الملاحقات الأمنية، ونعمل سوياً باعتبارنا سوريين وطنيين، ونتعاون مع بعضنا البعض، دون تقسيمات المعارضة والموالاة. وبعد خمس سنوات، نطرح حواراً سياسياً، يتطرق إلى المشاركة السياسية وقضايا التمثيل السياسي في سوريا”.
قيل آنذاك أن اقتراح كيلو حظي باهتمام بشار الأسد شخصياً. لكنه حينما ذهب إلى القصر الجمهوري، وقبل أن “تقع الفأس في الرأس” كاد أن يتوسّل لبثينة شعبان بعدم اللجوء للحلول الأمنية.
يقول ميشيل كيلو في تسجيله الصوتي: “قلت للسيدة بثينة، وتربطني بها علاقة وثيقة تعود إلى تلك الآونة حينما كنا نعمل سوياً في هيئة تحرير مجلة “الآداب الأجنبية”، قلت لها بالنص: “كرمال الله لا تلجأوا لحل أمني” لأن المسألة لم تعد مثلما كانت في عام 1980، حزب ومنشقون عنكم تمردوا في إطار صراعات بين دول عربية، فهناك مشكلة كبيرة في سوريا اليوم. المعارضة
والمشكلة اليوم لها علاقة بالشباب، بالبطالة، بنمط التنمية، وإدارة الدولة، والمشاركة السياسية، وبالجسم الاجتماعي الهائل الذي نما خلال أربعين عاماً من حكمكم، وتقدم، وصار لديه مئات الآلاف من المهندسين والأطباء والمحامين، ممن لم يعد لديهم أي مكان في البلاد. المشكلة في انفرادكم بالسلطة، والثروة، والإدارة والتعليم والإعلام وكل شيء. وتلك قضايا لا تعالج أمنياً أو عسكرياً، بل تحتاج إلى حلول اجتماعية وسياسية وتنموية واقتصادية وثقافية.. إنها قضية وعي.
ولو استخدمتم حلاً أمنياً من فوق، سيأتيكم حل أمني من تحت.
عندئذ سنضيع جميعاً، وأولنا سوف يكون الرئيس بشار الأسد”.
يقول كيلو في تسجيله الأخير إن رد بثينة شعبان كان: “والله ما بيخلّوه”. وحين سؤالها عمّن تقصد بكلماتها، أجابت: “أستاذ ميشيل، إنت بدك مين يقولك شو الوضع بالبلد؟ ما بيخلّوه”.
يا الله! كم تبدو كلماتك صديقي ميشيل بعيدة الآن، بعدما لم تكتف الفأس بالوقوع في الرأس، وإنما شجّته وقسّمت الجسد السوري إلى أشلاء بين الكتائب والألوية والفرق والتنظيمات والجماعات التي يمتلك كل منها “حقيقته المطلقة”، ويدافع كل منها عن “سوريا الخاصة به”، حتى بات شعبنا السوري يجتمع في اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف ليناقش “ألف باء” الدولة، وحتى أصبحنا نسعى بداية لتعريف مبدأ “السيادة” التي أضعناها حينما لم يستمع أحد إليك على مدار أربعة عقود. المعارضة
لقد رحل ميشيل كيلو، لكن النضال مستمر، رحل ميشيل كيلو لكن سوريا باقية فوق الجميع. لعل ذكرى المناضل الطاهر النبيل تكون نبراساً لما يجب أن تكون عليه القيادة في دمشق والمعارضة الشريفة، المنزّهة عن الهوى، والبعيدة عن رياح المطامع الخارجية، التي تسعى لنهش الجسد السوري، والاصطياد في الماء العكر، ومحاولة استغلال لحظة الضعف الراهنة، لتحقيق مآرب سياسية وشخصية ضيقة، ستدفع الأجيال القادمة ثمنها غالياً من حريتها واستقلالها والسيطرة على مواردها.
السلام لروح المناضل الشريف ميشيل كيلو، الذي ضرب لنا بحياته ومشواره النضالي الثري مثالاً يحتذى، وطريقاً لمن يريد الخلاص لسوريا الأبية وشعبها العظيم. الم
—————————-
=========================
تحديث 22 نيسان 2021
———————————
المثقف الأسدي متمنياً موت الآخرين/ علي سفر
قبل سنتين أو أكثر، تواصل معي أحد المثقفين، ممن يحسبون أنفسهم على المؤيدين العاملين في مؤسسات النظام الإعلامية والثقافية، بهدف مساعدتي وآخرين من الكتاب المعارضين على تسوية أوضاعنا، والعودة إلى “حضن الوطن” -بحسب توصيفه- معززين مكرمين!
لم أناقش الرجل في مساعيه، بل شكرته عليها، بعد أن قلت له إنني لا أريد العودة، لأن المسألة ليست شخصية، وإن ما كنا نسكت عنه قبل الثورة، من ممارسات النظام وأجهزته، بذريعة الحفاظ على البلد، وعلى وجودنا فيها كمواطنين، لم يعد من الممكن الصمت حياله بعد أن باتت سوريا مسرحاً لأكبر مذابح العصر الحديث، وقد ارتكبتها زمرة حاكمة، تواطأ العالم وعقوله المافيوية على حمايتها.
لم يعد إلى دمشق أحد من الكتاب الذين طرح الرجل أسماءهم أمامي، وتحول هو ذاته بعد فترة وجيزة إلى أحد الأشخاص المغضوب عليهم، فيكتب في صفحته على فيس بوك، عن سوء التعامل معه في مؤسسات النظام، وعن جحود القائمين عليها بحق من عمل فيها قبلهم!
ما وصلني من محاولة هذا الشاعر، هو إحساس واضح بأن ثمة مساحة ناقصة في المشهد الثقافي السوري، قوامها؛ الأسماء التي غادرت بعد قيام الثورة، لا يمكن تجاهلها، ويتوجب استعادتها!
ولكن المحاولة بذاتها لا تعني شيئاً، طالما أنها مبنية على غض النظر عما جرى ويجري في سوريا كلها، وفي كافة طبقات وشرائح المجتمع السوري، وافتراض أنه يمكن حل إشكال هذه الفئة مع النظام، عبر استعادة أفرادها، من خلال العفو عنهم!
وفي جهة مقابلة للشريحة التي يمثلها هذا الشخص، ثمة فئة واسعة من المثقفين المؤيدين، الذين يشعر المرء بأنهم قد تنفسوا الصعداء بعد خروج المعارضين، فقد شكّل هذا فرصة لمحدودي الموهبة منهم للتمدد في المشهد شبه الفارغ، والحصول على المكاسب، والأعطيات!
وقد انعكس مثل هذا الوضع على السطح إنكاراً لوجود الآخرين، الذين لا يجب أن يتم تذكرهم، ولا حتى مرور أسمائهم في السياق!
وحينما يضج فضاء مشترك بين السوريين كشبكات التواصل الاجتماعي، بالترحم على أحد هذه الأسماء كالراحل ميشيل كيلو، لن يخفي هؤلاء المؤيدون شماتتهم، مع سعادة واضحة تقريباً، بأن المعارض الذي قضى في المنفى لم يعد حياً لوطنه، وأنه قد مات في الخارج ما يعني أنه قد فشل في مسعاه أي رحيل النظام، ولا يخفي البعض منهم رائحة القذارة التي تخرج من منشوراتهم، حينما يتمنون موت جميع المعارضين!
ما وصلني من محاولة هذا الشاعر، هو إحساس واضح بأن ثمة مساحة ناقصة في المشهد الثقافي السوري، قوامها؛ الأسماء التي غادرت بعد قيام الثورة
يزدهي المثقف الأسدي النمطي بكونه ما زال على الأرض السورية، بينما بات الآخرون الذين “وقفوا على الضفة الأخرى” كما يسميهم هو وغيره، مبعثرين في مشارق الأرض ومغاربها!
قدرته على تحمل قمع النظام، وإغماضه عينيه عن رؤية المذبحة المستمرة منذ عقد بحق السوريين، وهذه صفات تنقص من إنسانية الإنسان عموماً، يحولهما بالكلام المبتذل عن المؤامرة والتصدي لها، ومواجهة العملاء، إلى ميزات، تتكفل بوضعه وترسيخه ضمن حظيرة المرضي عنهم، فيضمن بهذا وذاك قليلاً من الجعالات، وكثيراً من الادعاء بتملك صفات الوطنية، التي يوزعها بمقادير، فيصبح الموالون كاملين، بينما يعاني أولئك المشكوك بهم من نقصان فادح في صفاتهم، وانتمائهم، حتى أمسوا ممن تجوز عليهم وفيهم سياسة إعادة التأهيل في المعتقلات والسجون!
يقسّم أحد دراميي النظام المعارضين، وفق معاييره إلى ثلاث فئات رئيسية؛ “فئة أكابر التكنوقراط، وهؤلاء باعوا مهاراتهم ومواقفهم لجهات خارجية مخابراتية ذات واجهات ثقافية، وقبضوا الثمن، وما زالوا يبيعون ويقبضون.
فئة المثقفين الناقمين على الأوضاع، وهؤلاء ربطوا مصيرهم بالفئة الأولى، وهم الآن يعانون، لأن الأفق بات واضحاً بالنسبة لهم، ولم تعد خدماتهم مطلوبة كما في السابق.
الفئة الثالثة تشمل المخلصين المخدوعين من بسطاء المثقفين الذين استُخدموا كثيراً، وقبضوا قليلاً، وهم حالياً بين نارين، إذ يجدون أنفسهم في منتصف النفق، العودة بالنسبة لهم غير مغرية ولا مجدية والاستمرار هو ضرب من الانتحار”.
وبغض النظر عن أن منح الشخص لنفسه القدرة على تقييم الآخرين، بهذه الصفاقة، هو نوع من التفكير الذي تملكته أدوات السلطة ذاتها، فإن الاسترسال في الحديث عن الفئات الثلاث تبعاً للخيارات التي مضوا فيها، ودون بحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، لا يشبه في واقع الأمر سوى أن يدفن المثقف رأسه في الرمل، كالنعامة، منعزلاً عما حوله، ومفترضاً أن عالمه القاتم المحشو بالغبار، هو حقاً العالم الحقيقي، الذي يمنحه كل صفات الحكمة، وملكات التفكير السوي.
وهو في حمأة التقاطه للأفكار التي تمنحه الحماسة، يتجاهل أن شريحة التكنوقراط، والتي يسخر منها باستخدام تعبير “الأكابر”، لم يحدث أنها قامت بمغادرة البلد والوقوف في صف معارضة النظام، بسبب الثورة، بل إن هذا بدأ فعلياً منذ زمن طويل، وتحديداً منذ أن تولى البعثيون السلطة، واتبعوا سياسة خنق الرساميل الوطنية وتطفيش الكوادر التقنية، التي لم تجد في سياساتهم أي أفق لتطوير البلد، فقررت أن تغادر لعلها تجد مستقبلها في أمكنة أخرى، وهذا ما جرى في الخمسين سنة الماضية والتي حكمت فيها عائلة الأسد سوريا.
وهنا لابأس من التذكير بأن هجرة العقول التي يسخر منها كانت تتناسب طرداً مع السياسات الفاشلة لحكومات النظام، وتحول البلد شيئاً فشيئاً إلى مزرعة للعائلة، يجب على الجميع أن يكونوا عبيداً فيها.
وأيضاً، ينسى أو يتناسى الكاتب الذي دأب قبل الثورة على الكتابة عن فساد أهل السلطة، ثم تحول إلى واحدٍ من المتحمسين لها، أن يحدثنا عن أسباب النقمة التي تجعل من المثقفين ينحازون إلى المؤامرات على النظام الذي يحكم بلدهم!
وأظن أن إسباغ الصفات السيئة على المجموعة البشرية، بهذا الشكل لا يخفف منه التواري وراء التوصيفات البريئة، فهو يفترض أن الجميع قد باعوا أنفسهم مقابل “قبضة من نحاس”، دون أن يعرف أحد لماذا فعلوا هذا؟ فهل ولدوا خونة؟ أم أنهم كانوا خونة مستترين، وحينما جاءت الفرصة، كشفوا عن أنفسهم، وانساقوا وراء المصالح، وها هم الآن يجنون ثمرة عملهم، خيبة، وخسارة، وفقدان أمل!!
ويعود إلى تكرار الأمر ذاته في الحديث عن الفئة الثالثة التي يجد أفرادها أنفسهم في منتصف النفق!
هنا، يشعر القارئ بأن هذا المثقف السلطوي، يبني خطابه وفق منحيين؛ أولهما تجريم الآخرين بالخيانة، دون توضيح الأسباب التي أدت إلى تحولهم لخونة، وهو يصمت عن الأفعال التي يقوم بها هؤلاء وتستوجب اتهامهم بذلك، فلا يجرؤ أن يقول إن هؤلاء قد عارضوا نظام الأسد، وإن كل ما فعلوه لم يكن أكثر من مشاركتهم في سياق فعل مجتمعي عام هو الثورة، وهي أفعال لا تعد جرائم، سوى في العرف الأسدي!
وفي المنحى الثاني، ومن خلال التدقيق في ملفوظ الكلام الجغرافي، يذهب هذا “التنويري” السابق إلى جعل الذين يتحدث عنهم الآن في نفق، وهو يفترض بالتالي أن موقعه هو تحت الضوء، وإذا ما جمعنا ما تقدم به في البداية وما تأخر من تخرصاته، ستصبح سوريا الخاصة به هي “تحت الشمس”، بينما يترامى الآخرون في شتاتهم وتحت الأرض.
أليس هذا ما دأب الأسد على التفوه به حينما يتحدث عن المعارضين لحكمه؟ مضافاً إليه ما لا يمكن طمسه من مشاعر الغيرة والحسد والتمني لو أن أحداً من هؤلاء لم يتمكن من الفرار، واختفوا في مجاهيل الموت الوطني!
تلفزيون سوريا
——————————–
عودة السؤال مع رحيل ميشيل كيلو/ سوسن جميل حسن
مع كل موت لشخصية عامة أو مؤثرة في الراهن السوري، تسترجع الذاكرة لحظة مشابهة، وما رافقها من سجال في الشارع، وكأن الزمن لا يتحرّك، والطاقة الكامنة فيه تتقد وتتفجّر من جديد أقوى من السابق. تذكّرني وفاة الكاتب والسياسي السوري المعارض، ميشيل كيلو، بلحظات مشابهة، وتعيدني إلى ما كتبتُ مرة، بعد رحيل المفكر السوري صادق جلال العظم، في مقالتي المعنونة “ليس رثاء لصادق جلال العظم”، من على هذا المنبر (العربي الجديد)، والتي كانت في الواقع رثاءً له، “لا أجيد الرثاء، ولا أعرف أن أحزن إلا بمفردي، فحزن الفقد أمر شخصي كما أفهمه، بل ذاتيّ متطرّف في ذاتيّته، المشاعر التي يتركها فرد رحل تولّدها الفجوة التي تزداد عمقاً واتساعاً مع الزمن، فجوة المكان الشاغر الذي كان مليئاً بالحياة مفتوحاً على احتمال المزيد، عصياً على الاكتفاء، لكن صادق جلال العظم لم يكن إنساناً ذاتياً بالنسبة إليّ، فأنا بالكاد صافحته مرةً قبل أكثر من ثمانية أعوام (حين كتبت المقالة) مصادفة في دمشق عندما كنت بصحبة الراحلة إلهام زوجة ممدوح عدوان”. كذلك فإنني بالكاد التقيت بميشيل كيلو مرتين منذ مدة طويلة في إحدى السهرات في مدينتي اللاذقية، لكنني أكنّ لشقيقه، زميلي في المهنة الدكتور (الطبيب) عيسى كيلو، كل الود والتقدير، ما يفتح باباً على حزن شخصي أيضاً. لكن، هل يمكن أن يمرّ رحيل شخصياتٍ انشغلت بالقضايا العامة، وساهمت في طرح الأفكار الفاعلة في إنارة الوعي العام، من دون حزنٍ كبير، ووقوفٍ في لحظات تمعّن وتأمّل وتفكّر في الحالة السورية، وفي تجارب تلك الشخصيات؟
لقد دارت السجالات الحامية بين شريحة كبيرة من السوريين على صفحات التواصل الاجتماعي، وكما هي العادة أداروا حروبهم العارمة بكل ما أوتوا من قدرة وعزم على المحاسبة، وأن يكون بعضهم ديّاناً تجاه بعض، على مذبح الوطنية والإخلاص والتفاني في مواجهة المؤامرة التي يتعرّض لها وطنهم، وكل طرفٍ يبيح لنفسه امتلاك الحق الحصري بالوطن والوطنية ومجازاة الآخر ومحاسبته بأقصى ما يستطيع، باعتباره أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، وهنا القضية.
الموت حقّ وحقيقة. هذا بديهي، مع أن الموت في سورية اتخذ سياقات أخرى. ولموت ميشيل كيلو الذي أمضى أكثر من نصف عمره في النضال، وفي المعتقلات فترات عديدة، بجائحة كورونا، وقع مغاير، لكن ما لا يموت هو الفكرة، فكيف بفكرٍ ترك قواعده ومبادئه وأهدافه بين أيدي من هم بحاجة إليه، وشكّل بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاعدة بياناتٍ لاستلهام تجاربهم في بناء أوطانهم بحسب ما يطمحون، فيما لو قيّض لهذه الأجيال أن تعود إلى القراءة.
في رسالته التي وجهها الراحل عبر “العربي الجديد” إلى السوريين والسوريات، واعتبرت بمثابة وصيّته، كان فيها ما يشبه اعترافاً بأخطاء ارتكبت والاعتذار عنها، وهذا أمرٌ يُحسب له. ولا بدّ من الاعتراف بأن الخطأ مفهوم علمي، فمن يعمل في أي مجال يخطئ، فكيف في مجال السياسة، المتعلقة بالشأن السوري الذي ما زال العالم مختلفاً حوله؟ أمّا الحجة الدامغة بالنسبة إلى جمهور من يتمسّكون بنظرية المؤامرة، فكانت في التسجيل الصوتي الذي يعرّف فيه ميشيل كيلو عن نفسه ببطاقته الشخصية ويشيد بجبهة النصرة، وهذا ما شكّل البرهان الأخير في نظرهم على مسؤوليته عن تمزيق الوطن، بالحرف هذا ما قاله بعضهم. بالنسبة إلى الجمهور في اتساعه هذا، ما كان من تفاعله مع موت ميشيل كيلو كما سبقه من موت صادق جلال العظم أو الطيب تيزيني أو مي سكاف أو فدوى سليمان وغيرهم من الشخصيات العامة المؤثرة التي كان انحيازها واضحاً وقويّاً إلى الحراك الشعبي منذ البداية.
في المقابل، كان هناك شبه إجماع على مستوى النخب، الثقافية والعلمية والمجتمعية موزعة بين الداخل في كل مناطق نفوذه والخارج، على نعيه والحزن عليه، وإنصافه بوصفه شخصيةً وطنيةً، كان همّها العمل من أجل الشعب وقضاياه المحقة. لكن، هل يكفي هذا أمام الواقع الرهيب الذي وصلت إليه سورية ووصل إليها السوريون؟ هل بات للنخبة دورها الفاعل وتأثيرها في الرأي العام، بعد أن تبين مدى فشلها في تكوين وعي عام في العقود الماضية. يعود السؤال حارقاً صارخاً بعد سنوات عشر من الدمار والانهيار والتشريد: لماذا فشلت الثورة؟ بل هل هي ثورة من الأساس؟ لقد تكشّف الواقع باكراً في عمر الحراك عن فجوة عميقة واسعة بين النخب والقاعدة الشعبية، النخب التي لم تستطع أن تُحدِث التغيير المرجو في وعي الشعب، على الرغم من تضحياتها والأثمان الباهظة التي دفعتها في مقارعة الطغيان. ولكن أمام لحظة الحقيقة تبين أن الفواتير كلها راحت أدراج الرياح، وأن النسيج المجتمعي بدا متهتكاً ضعيفاً غير مسلّح بالوعي اللازم من أجل تحديد أهدافه وقضاياه. عقود من القمع والاستبداد أفرغت الحياة الفكرية، وشلت الحياة السياسية، وزجّت العامّة في حالة من الخواء الروحي والمفاهيمي، في وقتٍ كانت الجماعات الدينية هي الأكثر تنظيماً والأوسع كوادر والأقدر على الولوج في عمق الروح الجماعية “التي كانت تمتلئ بالخواء”، فارتمت الشرائح الفقيرة والمهمّشة التي راحت تزداد نمواً واتساعاً في أحضان تلك الجماعة. لذلك استطاعت الجماعات الإسلامية السيطرة باكراً على الحراك، وخطفه لمصلحتها.
لم تستطع الأحزاب والتيارات اليسارية في سورية تشكيل قاعدة اجتماعية، وتعزيز وعي شعبي بأهم المرتكزات التي تبنى عليها الدول الحديثة القائمة على مبادئ الديموقراطية والحقوق والعدالة الاجتماعية والحريات وعدم التمييز وانفصال الدين عن المجال العام والسياسة. وبالتالي، كان الخوف باكراً لدى قسم كبير من الشعب من التغيير، ومن الخطاب الإقصائي الذي علا باكراً أيضاً من الجماعات الإسلامية المتشدّدة، كجبهة النصرة التي حيّاها الراحل ميشيل كيلو حينها، وكانت تلك من أخطاء وقعت فيها قوى الثورة. وهنا تحضر قرينة في البال، عندما خاطب الراحل صادق جلال العظم النخب المثقفة من القوميين العرب، والناصريين، ويساريي تلك الفترة، ما بعد هزيمة حزيران، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ثوريين. “إن كنتم تعتبرون أنفسكم ثائرين، فعلى ماذا أنتم ثائرون؟ على الاستعمار فقط؟”، ألا يمكن استمرار هذا النهج، وتوجيه السؤال إلى نخب اليوم الثورية: على ماذا ثرتم؟ على إسقاط النظام السياسي فقط؟ والطغيان الذي صادر الثورة، وصادر المجال العام بأجمعه؟ وخطابات الفصائل والأطراف التي تهيمن على جزء من الأراضي السورية، وتفرض سطوتها ونهجها على الشعب تحت نفوذها بالأسلوب نفسه، وبالنهج السلطوي الشمولي القمعي نفسه؟
إذا كان الهدف من انتفاضة الشعب إسقاط النظام فقط، فتلك مصيبة، بعد أن سقط الوطن، وتقسّمت الأرض، وارتهن القرار والإرادة للخارج، وجرى القتل والتهجير والتشريد والتجويع. مصيبة ألّا يكون هناك بدائل لدى الشعب، أن ينتظر الشعب ديكتاتورياتٍ وطغياناً أعتى، عندما افتقد الشعب إلى البدائل التي تُرضي طموحه، ورأى أن البديل المطروح عن النظام طغيانٌ آخر يرمي إلى فرض شريعته بالكامل على الشعب. انزاح قسم كبير منه إلى كفة النظام. هذه حقيقة ومؤشّر على فشل ذريع، وها هي الانتخابات قادمة، على الرغم من مهزلة التنافس وتعدّد أسماء المرشحين، إلّا أن ما يمكن استنباطه، في استقراء أولي، يفيد بأن لا شيء تغيّر، وأن استبدال كلمة انتخاب بكلمة استفتاء في الدستور عملية خلّبية ليس أكثر.
بعيداً عن الحل السياسي الذي لم يعد بيد السوريين، وإذا لم يكن هناك إرادة دولية واتفاق دولي وإقليمي على الحل، فلن يكون في المستقبل القريب. لكن هل من المعقول الانتظار إلى حينها؟ الاشتغال على الوعي الجمعي، وتعريف الناس بقضاياهم الراهنة، وطرح تصور عن مستقبلهم أمر ضروري، لأن البناء والاستمرار مرهونان بالفترة التالية، فترة ما بعد فرض الحلول السياسية. الشعب بحاجة إلى استراتيجية وخطط من أجل حياة مستدامة، وهذا لا يصحّ من دون وعي جديد وسليم.
السلام لروح السوري ميشيل كيلو، والصبر الجميل لهذا الشعب الذي احتمل أكثر من طاقته بكثير. الصبر الجميل له حتى يستعيد عافيته الروحية قليلاً، ويبدأ بالتفكير المجدي النافع بواقعه واستنقاعه، وكيف السبيل للخروج من لجّته الحارقة. والدعوة إلى النخب بأن تعيد حساباتها وقراءة تجاربها، علّها تتمكّن من إحداث المفارقة اللازمة، وتستطيع رمي الحبل إلى الشعب لانتشاله من حمأته، كي يسمو بعضه على التخوين المجاني بحق بعضه.
العربي الجديد
—————————
ميشيل كيلو و”أمة السوريين المتخيلة”/ رستم محمود
برحيل الكاتب والسياسي السوري المعارض ميشيل كيلو، تكون “النزعة الوطنية السورية” قد فقدت واحداً من أهم منظريها ودعاتها. فقد بقي كيلو يُبشر لعقود طويلة بضرورة الولاء والارتباط والإيمان بوحدة الحال والمصير والهوية التي تجمع عموم السوريين، تحت سقف وفضاء من “الوطنية الجامعة”، المتأتية من إرث وحقيقة أن السوريين أمة واحدة، سياسياً وثقافياً. وأن ذلك الشيء سباق ومتفوق وأكثر نبالة وجدارة وحقيقية من كل أشكال التفرقة القومية والدينية والطائفية والمناطقية التي تُغرق السوريين راهناً، التي كان يراها كيلو وليدة ظرفٍ سياسي خاص فحسب، ناتج عن الاستبداد المديد. حيث سيعني وسيؤدي إسقاطه حسب الراحل إلى نهاية كل اشكال التفرقة والصراعات البينية تلك، وتالياً العودة إلى الأصول “البريئة” التي كانت.
عبر كتاباته ومبادراته ونشاطه السياسي شديد الحيوية، وحتى عبر مروياته وحكاياته الشفهية التي ما كانت تنتهي، كان كيلو يقدم العشرات من الدلائل والمحاكمات التي تحاول إثبات وجهة نظره تلك. حتى أن الكتاب الموسوعي الوحيد الذي ألفه في حياته “من الأمة إلى الطائفة”/دراسة نقدية لحكم البعث والعسكر في سوريا، كان محاولة مُضنية لتوثيق وشرح وتأكيد ذلك باستفاضة مطولة.
ثلاثة منابت في التاريخ السياسي السوري الحديث، كانت مصدراً لتشكل ذلك النوع من الوعي “الرومانسي” الذي آمن وبشر به الكاتب والسياسي الراحل. فمن جهة كان كيلو واحداً من أبناء الطبقة الاجتماعية/الاقتصادية السورية الأكثر هامشية وهشاشة ضمن المشهد السوري طوال عقود الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن المنصرم، من الذين اندفعوا بكثافة استثنائية للإيمان والانتماء إلى الأحزاب السياسية والتيارات الإيديولوجية الرومانسية، الشيوعية والبعثية والقومية السورية…إلخ. وذلك كفعل جمعي للتخلص من رداءة أحوالهم التي كانت في الهوامش الاقتصادية والاجتماعية، وتالياً للصعود في سلم المتن العام للبلاد، الذي كانت تحتكره الإقطاعيات والبرجوازيات المدينية. كان الانتماء إلى تلك التيارات دافعاُ لأبناء هذه الطبقات للتصريح و”الادعاء” بتجاوزها للفروق والصراعات والحساسيات الطائفية والمناطقية والقومية، وانتماءها وولاءها لما هو أوسع وأرفع منها، الأمة والوطن وأشياء من ذلك، والاستماتة في سبيل التماهي مع مثل ذلك النوع من الخطاب والصورة حول الذات، بغض النظر عن حقيقتها من عدمه.
المنبت الآخر كان يتمثل بـ”سيرته العائلية”. فكيلو كان نجل دركي مديني مسيحي، سمحت له سنوات الانتداب الفرنسي على سوريا بالمشاركة المتساوية في مؤسسات الدولة السورية وحياتها العامة، وبذلك تجاوز أرث المسألة المسيحية المشرقية، التي كانت محل شقاق وصراع طوال سنوات التحول من الدولة الدينية إلى نظيرتها المدنية في عموم منطقة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، منذ التنظيمات العثمانية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الربع الثاني من القرن العشرين، أثناء فترة الانتداب الفرنسي. كان المسيحيون السوريون بعمومهم، وأبناء المدن الأرثوذوكس منهم تحديداً، يرون في فضاء الوطنية المدنية تلك خلاصاً عمومياً لهم، وفتحاً لباب المشاركة المتساوية في الفضاء العام، وإن ذلك المكسب يجب عدم الاستغناء عنه بأي شكل، والتماهي معه في كل وقت وعبر أية أداة كانت.
فوق الأمرين، فإن ذلك النوع من الوعي التبشيري الرومانسي، وغلبته في المشهد السوري، والذي كان الراحل واحداً من ألمع معبريه، كان نتيجة طبيعي لـ”طغيان” حضور الثقافة والمثقفين لعقود طويلة في المشهد العام المُعارض للنظام الشمولي في سوريا. فالمحق الذي طال جذور القوى والشخصيات السياسية السورية من قِبل النظام الحاكم، دفع بنخبة من المثقفين السوريين لرفع أصواتهم في وجه الشمولية، وكان الراحل ميشيل كيلو واحداً من أبرزهم، منذ مداخلته الشهيرة في اجتماعات الاتحاد العام للكتاب العرب عام 1979. حيث أن المخزون والوعي الثقافي الذي كان غالباً في ذوات أبناء هذه النخبة المعارضة، كان دافعاً لأن تكون خطاباتهم ودعواتهم السياسية متخمة بالتبشير المفارق لتعقيدات الأحوال السياسية السورية، ومحاولة تجاوزها عبر أنواع من الرومانسية الفوقية، غير المبالية بـ”الحقائق السورية”، الأكثر تركيباً وتكويراً.
في المحصلة، كانت الصورة المبسطة التي ركن إليها الكاتب والسياسي الراحل كامنة في الإيمان الراسخ بوجود وصلابة الوشائج والمصالح بين مختلف أبناء “أمة السوريين”، وأن الاستبداد المديد هو الذي عكرها وشيّد أشكال الصراع الداخلي بين السوريين هؤلاء، وأن نضالات السوريين يجب أن تتكثف للإيمان والعودة إلى الأصل ذاك. تلك الصورة الرومانسية المبسطة، وإن كانت بهية، إلا أنها كانت ذات أثمان باهظة، ثقافياً وسياسياً.
فالركون إليها يعني أولاً بأن الطائفية في سوريا ذات منبع واحد فحسب، هو السلطة الحاكمة. وتالياً تنزيه التاريخ السياسي السوري، في مراحل تأسيس الدولة السورية عبر البرجوازيات المدينية ولاحقاً أثناء تشكيل تيارات الإسلام السياسي، تنزيهها من أية نزعات وخطابات واستراتيجيات طائفية، كانت سابقة لهذا النظام السياسي، مُعلنة وواضحة أحياناً، ومُضمرة في أمثلة وتيارات أخرى، لكنها موجودة وأصلية في بنية وخيارات تلك القوى، لم يفعل الاستبداد السياسي ربما إلا بزيادة وتيرتها واستقطابها. الأمر نفسه ينطبق على التطرف القومي، الذي لم يكن بعثياً سلطوياً فحسب، بل يكاد أن يكون شاملاً ومغطياً لكل التيارات السياسية وأشكال الوعي الجمعي السورية.
هذا التفصيل الذي دفع السياسي الراحل لعدم الانتباه لخطورة الثقة والترويج لتيارات الإسلام السياسي، الإخواني في مراحل ما قبل الثورة، ومن ثم لأكثر تنظيمات الإسلام السياسي أصولية خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، بما في ذلك جبهة النُصرة، التي لم تنكر علاقتها بتنظيم إرهابي مثل تنظيم القاعدة منذ تأسيسها في السنة الأولى للثورة السورية. فالأساس في وعي كيلو كان الثقة الإيجابية بكل ما ومن يُعلن معارضته للنظام الحاكم.
الثمن الآخر كان كامناً في الإيمان والولاء المُطلق لأولوية “الكيان والأمة” على ما قد يتنافى معها من خيارات سياسية لأبناء الجماعات السورية غير المركزية، التي قد تطلب بمجموعة من الحقوق غير المطابقة لما قد يُعتبر وحدة الأمة ومركزية الكيان السوري. ففي النتيجة النهائية، كان ذلك الإيمان بحقيقة وجود أمة ناجزة وكيان سياسي مُطلق شكلاً مُقنعاً من القومية المركزية غير المُعلنة، التي تنعكس على شكل مواقف وخطابات متشنجة ومناهضة لأبناء الأقليات القومية والمناطقية وحتى الطائفية غير المركزية، التي يُمكن أن تؤمن بحقها وسعيها لما يناقض ما يعتبره الآخرون “حقائق الكيان والأمة”.
على أن أبلغ معضلة في ذلك النزوع الرومانسي الذي كان في وعي وشخصية الراحل كيلو، ومثله الكثيرون من المثقفين السياسيين السوريين الذين تسيدوا المشهد السياسي السوري، وبالرغم من ثراء تجربته النضالية العنيدة في مواجهة الشمولية، وطاقته الدائمة على المبادرة والتنظيم بين مختلف القوى والخيارات السورية، كان في الاستعصاء الدائم في قدرته/قدرتهم على تقديم ما يتجاوز الخطابات الرومانسية الفوقية، التي كان يعرضها/يعرضونها كحلول وسياقات لحل للمعضلات السورية شديدة التعقيد.
فترسانة المقولات والأحاجي حول الدولة المدنية الديمقراطية والمواطنة المتساوية، أثبتت في أكثر من مثال إقليمي، وفي التجربة السورية طوال عشرة سنوات كاملة من الحرب الأهلية، عدم قدرتها التامة على تقديم اجابات وحلول حقيقة لأشكال الصراع الداخلي والحروب الأهلية الحقيقية في البلاد، التي تحتاج إلى رؤى أكثر جسارة وتصالحاً مع وقائع الأحوال، وأقل انتباهاً لمستوى التزامها بـ”أيديولوجية أيام الصبا”.
——————————–
ميشيل كيلو الجمع الخلاق بين الفكر والممارسة../ الدكتور عارف دليلة
في ” عصر المعجزات ” يعود ميشيل من عالم الغيب ليبارك للجميع ، بصوته الخفيض من تحت كمامة الأكسجين ، بقدوم شهر رمضان المبارك ، وليترك فيهم وصيته الأخيرة ، وليرحل عن دنياهم التي لم يعد فيها ما يسر الناظرين !
قبل أيام تحدثت مع صديقنا المشترك نادر جبلي المقيم في باريس لينقل بصوتي رسالة صوتية إلى ميشيل بسرور الجميع بسماع تهنئته ووصيته الحكيمة بصوته بعد عودته إلى الانتعاش والتعافي ، ولم يدر بخلد أحد بأنها عودة الروح لساعات فقط ، وكان الأخ نادر قد حكى لي كيف أن ميشيل كان قد وصل إلى وضع ميؤوس منه في المشفى فقرروا نقله إلى مستشفى أفضل حيث عادت إليه الروح من جديد ، ولكن ، كما رأينا ، وللأسف الشديد ، فقط لكي يترك في السوريين وصيته الأخيرة ، ثم يفاجئنا بمغادرته ، وبشكل نهائي ، دنيانا إلى عالم الغيب !
لا أظن أن هناك سوريا واعيا له صلة بالشأن العام لم يصله وهج من ميشيل كيلو على مدى نصف قرن ونيف ، ثقافة أو أدبا أو سياسة، أو فكرا وفلسفة ، بشكل عام ، وبالأحرى من نشاطه العملي .
والأهم لدى ميشيل كيلو ، هو الجمع الخلاق بين الفكر والممارسة ، وعدم الانزواء في برج عاجي بعيدا عن الواقع والمجتمع والإنسان ، فقد كان له مساهمته الفكرية والعملية في معظم الأنشطة والتنظيمات الوطنية ، ولكن دون أن يصبح أسيرا لأي منها ، وبكلمة ، فقد كان مثقفا عضويا بكامل معنى الكلمة !
لقد برز نشاطه ، مثلا ، في باكورة أنشطة المجتمع المدني في ربيع دمشق ( لجان إحياء المجتمع المدني ) في أواسط عام 2000 والتي انتشر بيانها الأول على كامل المساحة السورية المكانية والاجتماعية ، وكنا ، كمكتب تنفيذي من 15 شخصا ، ننتقل من مدينة لأخرى لعقد الاجتماعات مع الكثيرين الذين كانوا ، تحت ضغط القمع غير المسبوق ، قد فقدوا الثقة بالسياسة ويئسوا من التفكير بالمستقبل . وإذ بالشعب السوري يخرج كالعنقاء من تحت الرماد وينظم ربيعا بالغ الحيوية والنشاط غير مسبوق في العالم العربي !
وكان الأمل أن يثمر الربيع في صحرائنا القاحلة كل ما تحتاجه أمتنا لتخرج من عنق زجاجة التخلف والبؤس والاحتباس التاريخي إلى العالم الجديد المفتوح على التقدم والنهوض الشامل ، وبالأخص وهي تمتلك من المقدرات والطاقات المادية والبشرية ما لم يكن متاحا لأكثر الأمم ، بينما هي ما زالت محكومة بالطغيان والفساد ، والانحطاط والاستبداد ، أكثر من أي أمة أخرى في العالم !
فلماذا كان علينا أن نقبع في محاجرنا ، كالسلحفاة ، ولا نخرج إلى النور ، تحت ضغط الخوف من اتهامنا بأشنع الاتهامات ، مثل تقويض همة الأمة ، أو معاداة النظام الاشتراكي ( كذا !) أو التحريض على الحرب الأهلية ..إلخ ، كما حكى لنا ميشيل الكبير في برنامج “الذاكرة السياسية ” على شاشة ” العربية ” قبل ثماني سنوات ، كيف استدعاه ، مع صديق آخر ، أحد سجاني مثقفي الشعب السوري ليقنعهما بأنهم لم يقوموا باعتقالي ( في 9/9/2001) بسبب معارضتي للفساد ( كما كان يعرف القاصي والداني ) وإنما لأني كنت أحرض على الحرب الأهلية !!! ولما نفى ميشيل عني هذه التهمة وطالبه بالدليل ، فلم يكن لديه غير قولي :” إذا استمر تطورنا على هذا المنوال فإنه سيقود إلى انفجار اجتماعي ” ، عندها قال له ميشيل : إذا كنت صديقك وأراك تشعل السيجارة من السيجارة وقلت لك ” توقف عن التدخين وإلا فإنك ستصاب بالسرطان القاتل ، وإذا حدث لاحقا وأصبت فعلا ، فهل أكون أنا سبب إصابتك ، أم أكون أحرص عليك من نفسك وأنا أنصحك لكي تحمي نفسك من السرطان ؟ ” !
هكذا ” كنا عايشين !” ، محكومين بمن لايجدوا ما هو أجدى لحماية فسادهم واستبدادهم واستمرارهم في تدمير الدولة والمجتمع في سورية غير تلفيق الاتهامات للعقلاء والشرفاء لـ” تنظيف ” محيطهم منهم . ولم يطل الوقت حتى أصبح ميشيل نفسه نزيل أحد زنازين ” منتجع عدرا ” الذي بني في الثمانينات كأكبر ” مشروع” في خطط التنمية في الثمانينات في سورية ! ، وربما الأكبر من نوعه في العالم ! ، هذا في وقت كان الشعب السوري فيه يتلقى ” دورة تدريبية ” على الانتظام في طوابير المواد الضرورية ، ولكننا ، مع ذلك ، كنا عايشين أفضل منا الآن ، لأن الدخل كان ، بعد كل انهياراته انذاك ، أفضل منه الآن بثلاثين مرة على الأقل ، ولم تكن شركة “تكامل” الحالية ، صاحبة ” البطاقة الذكية ” قد ظهرت بعد ، كمنافسة لـ ” سيرياتيل “السباقة لها في الشفط والتشليح ونهب الدولة والمواطنين المعدمين ، والتي ظهرت آنذاك ، كـ “ثمرة ” لاعتقالنا كـ “محرضين على الحرب الأهلية ! “.
لم يكن ميشيل يوما متغيبا عن تفاصيل هذه الوقائع الميدانية، منعزلا في برجه الثقافوي العاجي ، كما يقبع معظم “مثقفي” الشعب السوري !
هذا ميشيل يقول في وصيته الأخيرة التي عاد من الغيب لساعات ليبلغها ، ثم يعود :
“اتحدوا ، وإلا فلن تبلغوا شيئا من الحرية والكرامة !
ابدؤوا مراجعة نقدية توضح ، بصراحة وبمسؤولية وبشفافية ، أين أخطأنا وأين أصبنا ، وكيف يجب أن نعيد بناء أحوالنا لنستطيع أن نتابع طريقنا نحو سورية الحرية والكرامة !”
في كتاب الائتلاف الذي ينعى فيه الراحل ميشيل كيلو ، يقولون : إنه كان عضوا بارزا في الائتلاف ثم استقال منه بسبب الاختلافات !
فهل يبدأ زملاؤه السابقون في الائتلاف بتنفيذ وصيته بـ “المراجعة النقدية “وتوضيح الاختلافات التي أودت بميشيل إلى الاستقالة ؟ بل هل زالت هذه الأسباب أم تعمقت منذ استقالته ؟ بالطبع ، على أن لا تقتصر المراجعة النقدية على إدانة الآخرين من أجل تبرئة الذات ؟
أليست أسباب استقالتك ، أيها الغالي الراحل ، من الائتلاف هي نفسها الأسباب التي جعلتنا ، أنت وأنا ، (وربما كثيرون آخرون) نحجم عن المشاركة في “المجلس الوطني من أجل أن يصبح أكمل تمثيلا للشعب السوري ” ( كذا !) عندما كنا نلتقي بأعضائه في باريس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011 قائلين “إنه ولد ميتا ، وما هكذا تكون قيادة الثورات” والأمر نفسه ، وعلى شكل أسوأ ، تكرر في الائتلاف ، الذي سمعتهم منذ أيام يناقشون سبب فشلهما ويجمعون على أن انشقاق هيئة التنسيق وعدم قبولها المشاركة بهما كان الضربة القاضية للمعارضة السورية وانشقاقها إلى معارضة داخلية ومعارضة خارجية ، وصدق المثل القائل ( جحا أكبر من أبيه ) فمن الذي انشق عن من ؟
بالتأكيد ، ليس هذا هو النقد الذي يريده فقيدنا الكبير ميشيل كيلو !
وأعتذر من كل من يعتبر في المكتوب المطول أعلاه “استغلالا للمناسبة ” وخروجا على تقاليد التعزية !
ولكني أعتقد أن أكثر ما يسر ميشيل هو الخروج عن تقاليد العزاء إذا كان من أجل الانشغال في الشأن العام بما هو مفيد ، طبقا لوصيته الثمينة !
الرحمة والسلام لفقيدنا الكبير ميشيل كيلو ، الحاضر الغائب دوما ، وأحر العزاء لرفيقة عمره الغالية أم أيهم وابنتهما وأخويها الكرام ، ولجميع محبيه .
الناس نيوز
———————
ميشيل كيلو لن يغيب إلّا قليلاً/ موفق نيربية
لو قلنا إن الكلام عن ميشيل كيلو ليس سهلاً ونحن ما زلنا تحت وطأة رحيله، أو كما يُقال: ما زال دمه بعدُ دافئاً!.. لكان أفضل ردّ لنا علينا هو أن حرارة ميشيل لن تنخفض مع الزمن، وربّما يمكن أن تزيد. لأنه كان ريحاً عاصفة مرّت في مساحاته التي أطلّ عليها، وخارجها، ولن تتخامد لوقت طويل.
استطاع ميشيل كيلو أن يملأ فراغاً هاماً في عالم الترجمة (ترجم أربعين كتاباً عن الألمانية)، والفكر السياسي، والثقافة الوطنية- الديموقراطية، وفي الكتابة السياسية (أنجز كتباً عديدة كان آخر اثنين منها في العامين الأخيرين، وكتب عدداً كبيراً من أهمّ افتتاحيات إعلام المعارضة، وعدداً هائلاً من المقالات السياسية)، وفي الإبداع (كتب روايتين على الأقل وطبعهما مؤخراً، وكان من أهم من أعرفهم برواية الشعر العربي القديم عن ظهر قلب)، ولكن أهمّ ما قام به هو التأثير والفعل في ميدان السياسة السوري، انطلاقاً من قدراته المذكورة تلك، إضافة إلى حيوية لا تنضب وإنتاجية تثير عجب من يتقارب معه.
كان ميشيل رائداً رئيساً للحراك الثقافي الديموقراطي في سوريا، وريثاً كبيراً لتلك الثلة من قادة التحوّل الذي ابتدأ في الثقافة السياسية بعد هزيمة حزيران: ياسين الحافظ وجمال الأتاسي وعبد الكريم زهور، وخصوصاً الياس مرقص، أستاذه وصديق عمره، والإنسان الأكثر تفاعلاً معه فكراً ونشاطاً. وبتلك الملكة استطاع أن يكون محوراً لالتفاف المثقفين السوريين الديموقراطيين في النصف الثاني من السبعينات، ومنسّق نشاطاتهم الأهم؛ والذي يؤلّف بين حركتهم والحركة السياسية المعارضة، بتوازن وتوليف صعبين ونادرين.
ذروة نشاط تلك الفترة في أواخر 1979، كانت حين رأت السلطة أن تلتقي بالمثقفين وتحاول محاورتهم أو إغواءهم. فكان لقاءً عاصفاً لم تشهد سوريا له مثيلاً منذ زمن بعيد، أبدع فيه الكتاب والشعراء والمفكرون في جَلد النظام وحفر أساسات للتغيير فيه. كان ميشيل لولبهم كما يُقال، ورائد توازع المهام من غير توزيع آنذاك.
ذلك الحراك، انصبّ في حراك اجتماعي سياسي كبير، بمساهمة النقابات المهنية وقوى التجمع الوطني الديموقراطي وغيرها، بالتوازي مع الحراك الثقافي المذكور وبالتفاعل معه. آنئذٍ تحرّك الشارع السوري في إضرابات واحتجاجات ومَوَرانٍ سياسي كبير، يكاد يكون انتفاضة أولى، أو تمريناً على ثورة لاحقة. ثم جاءت موجة القمع والاعتقال اللاحقة بعد ذلك لتشمل الكثيرين، ومنهم ميشيل كيلو بالطبع، الذي كان لصيقاً بحقله الخاص الثقافي، وبالحقل السياسي المعارض في نواته الفاعلة.
بعد خروجه من السجن، كان دأبه استمرار الحياة في جسد الثقافة والمعارضة الديموقراطيتين، وتابع نشاطه الحثيث في المجالين بشكلٍ مكتوم نسبياً، سواء في فرنسا حيث أقام لفترة من الزمن أو في فضاء الوطن البائس تحت نير الاستبداد المتجدد بمذابحه التي نفّذها في أوائل الثمانينات. رغم ذلك تابع ميشيل معالجاته لسياسات المعارضة، وكتب عدداً من افتتاحيات إعلامها أيضاً.
في أواخر التسعينات، حين لاحت نهاية الأسد الكبير في الأفق، وانتعشت الحركة الديموقراطية قليلاً، كان له دور رئيس (مع رياض سيف وآخرين) أيضاً في البدء بسلسلة لقاءات لم تنته بتأسيس “لجان إحياء المجتمع المدني” التي كان لولبها ومحراكها الدؤوب، وحركة المنتديات آنذاك التي كان أبرزها منتدى الحوار الوطني ومنتدى جمال الأتاسي، التي كان لها دور كبير في ربيع دمشق في مطلع الألفية الجديدة.
وفي عام 2005 وباسم “لجان إحياء المجتمع المدني” دخل مع الراحل حسين العودات خصوصاً في سلسلة من الترتيبات واللقاءات العلنية والسرية وكتابة المسودات مع القوى الأخرى على تنوّعها، انتهت بتأسيس جسم المعارضة الأكبر في تاريخ سوريا الحديث: “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي”.
وعلى السياق ذاته، كان لميشيل دور رئيس أيضاً في إنجاز البيان المسمّى” إعلان دمشق- بيروت، إعلان بيروت- دمشق” بتوقيع عدد كبير من المثقفين السوريين واللبنانيين معاً، للمساهمة في حلّ الإشكالية السورية- اللبنانية القديمة، التي تعاظمت كثيراً من خلال الوجود العسكري الأسدي في لبنان، الذي كان احتلالاً بشكل من الأشكال. وعندئذٍ نضجت الأسباب لدى السلطة لتعتقل ميشيل وتحكم عليه بالسجن من جديد مع عدد من موقعي ذلك البيان، الذي أصاب النظام في نقطة ضعفه ونبع شراسته.
وحين خرج ميشيل من السجن بعد سنوات ثلاث، لم تمنعه الحالة السياسية المتردّية، وتراجع النهوض الشعبي إلى حدوده الدنيا، من محاولة العودة إلى البدايات من جديد، لتنظيم قوى الثقافة الديموقراطية من أجل الهجوم التالي. إلّا أن الثورة فاجأته وفاجأتنا جميعاً، وتغيّر الاتّجاه وانتعش الحلم منذ اندلاع ثورة تونس، وخصوصاً مع اندلاع ثورة مصر. ولم يخيّب شعبنا آمالنا، وانطلق إلى الشوارع في آذار ٢٠١١، في أعظم ثورة في تاريخه.
كان ميشيل موجوداً بعدها في كلّ محاولات تنظيم القوى وتعزيزها، من المنبر الديموقراطي وهيئة التنسيق حتى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إلّا أنه لم يندمج عملياً- أو طويلاً- معها بسبب من عدم تلبيتها تماماً لمتطلباته السياسية أو لطموحه الكبير، وانشغل مع آخرين بمحاولة تأسيس قطب لتجميع الديموقراطيين وزيادة حجم تمثيلهم في الكيانات السياسية المعارضة، حتى دخل الائتلاف في منتصف 2013، وابتدأ عهد مختلف وملتبس كان يحاول من خلاله ألّا ينعزل عن السياق الرئيس، ولا يتخلّى عن قناعاته الديموقراطية، حتى أصبح ذلك مستحيلاً، والوضع لا يُطاق، فاستقال من الائتلاف مع آخرين- ونحن منهم-، حتى لا نكون شهود زور على مسار مفتوح على مصراعيه لقيادة الإسلاميين والإسلامويين، مع سياسات تزيد من التدهور والفشل شيئاً فشيئاً، بالتوازي مع ازدياد ارتهان قوى المعارضة تلك للخارج بعيداً عن تمثيل شعبها شكلاً ومضموناً.
بذلك أيضاً، لم يكن مسار حياة ميشيل كيلو الثقافية والسياسية كلها مستقيماً، بل كان كالحياة ذاتها، متعرّجاً ومتفاوتاً ومخطئاً في بعض الأحيان، وفي ذلك يمكن تدبيج كتب كثيرة… ولكنه عموماً كان حيّاً وحاراً وقريباً من الناس السوريين، وكان أيضاً فعّالاً ومنتجاً. ولم يكن أيضاً بعيداً عن محاولات المراجعة النقدية المستمرة، حتى لتحسب أنه يناقش ويجادل نفسه أحياناً، وهو يعمل على استنباط الخط والرؤية السليمين.
فكان من آخر ما قاله وأكثره أهمية وراديكالية وباعثاً على التأمل والمعالجة، ما ورد في سياق حديثه إلى صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أواخر العام الفائت، حين قال: “لقد كنا ساذجين.. كان ينبغي لنا إيجاد حلٍّ مع النظام، قبل أن يصبح الصراع السوري الداخلي جزءاً صغيراً من حرب”. وهذا مخيف في درجة اختلافه عن السائد، وفي احتمال صحّته غير الضعيف أيضاً.
*****
ميشيل كيلو،
ستكون جدالاتنا معك أقلّ حدّة بعد الآن، وأكثر اجتهاداً وعقلانيةً وحباً، ولعلّنا نكون أقلَّ اختلافاً أيضاً..
وفي كلّ الأحوال سوف نبقى معاً، ولن تغيب!
*****
رابطة الكتاب السوريين
————————–
=====================
تحديث 23 نيسان 2021
————————-
كيف تدمر الأنظمة السلطوية فكرة المواطنة؟/ رضوان زيادة
لم أستطع منع نفسي من البكاء على رحيل الصديق ميشيل كيلو، فقد كان من أوائل المعارضين الذين التقيتهم في دمشق ثم عملنا معا في لجان إحياء المجتمع المدني، وبعد الثورة تقاطع عملنا في أكثر من مؤسسة ومبادرة.
لقد تواصلت معه في اللحظات الأخيرة عندما كان في المشفى في باريس في محاولة منه الصمود في وجه هذا الفيروس القاتل وكان يكتب لي في أمور سوريا، كنت أسأله عن صحته وكان يجيب بالسؤال عن تطورات الأوضاع.
المهم كان ميشيل من أوائل من رفع لواء التركيز على فكرة المواطنة وواجب الدولة في مسؤوليتها في احترام حقوق إنسان مواطنيها.
لكن نظام الأسد أفلح في تطبيق سياسة العقاب الجماعي فتلك ميزة تنفرد بها السلطات الشمولية، معاقبة الجميع كي يرتدع الجميع، لم يكن ميشيل يوما في حياته انتقامياً أو ثأرياً رغم تعرضه للاعتقال أكثر من مرة، لقد كانت ولا زالت رغبته في أن سوريا تستحق مستقبلاً أفضل، وأن سياسة السلطة الشمولية لن تقودها إلى هذا المستقبل، بل إنها ستتجه بها إلى مزيدٍ من الانعزال والانحدار.
بمثل هذه المعاقبة تحوّل السلطة الشمولية علاقتك بوطنك من فكرة الدفع بالأفكار إلى صراعٍ شخصي، لقد تحول صراعنا ضد الأسد إلى أشبه بالصراع الشخصي، مع الإيمان أن من حق كل السوريين على اختلاف أرائهم المشاركة والتعبير من أجل التغيير وأن الإيمان بالوطن يعني الإيمان بوطنٍ يفتح ذراعيه للجميع كي يساهم فيه الجميع ويحلموا به وطناً لكل السوريين.
لكن تحويل الخلاف السياسي إلى صراع شخصي وعقاب عائلي، يحول المعنى النبيل من أجل التغيير إلى حقدٍ وانتقام، وربما هذا يفسر لماذا يتحول الصراع اليوم بين المعارضين السوريين في الخارج والنظام السوري إلى علاقة تقوم على الانتقام المتبادل أكثر من كونها خلافاً سياسياً، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى سياسات العقاب والانتقام التي تستهدف الردع والعقاب.
تلك هي بداية التدمير الشخصي لمعنى الوطن داخل نفوس السوريين عبر تحطيم فكرة الوطن لديهم، وزرع الخوف والتشكيك وثقافة الثأر والانتقام. وتتابع هذه السياسة بشكلٍ طبيعي إلى تدمير فكرة المواطنية وتحطيمها داخل نفوس السوريين وفي طموحاتهم ورغباتهم وآمالهم.
تلفزيون سوريا
———————-
ميشيل كيلو وفارس الخوري/ ناهد بدر
كنا طلابا بالجامعة نتهجى الحروف الأولى للسياسة، عندما تداولنا بالسر الكاسيت المسجل للمثقفين السوريين الشجعان الذين انتقدوا النظام الاستبدادي بكل جرأة وعمق، وكان ميشيل كيلو واحداً منهم. كان ذلك أول تعرفي على اسمه، وأول تأثير له على خياري للعمل السياسي المعارض للاستبداد.
نحن ننتمي إلى الجيل الذي انخرط في العمل السياسي المعارض في أواخر السبعينات، وكان ميشيل كيلو أحد المساهمين بتشكيل وعينا آنذاك. ففي مطلع عام 1980 نظم نظام البعث الحاكم في سوريا مؤتمراً للأدباء والصحافيين السوريين، بغية كسب تأييدهم تحت شعار “رصّ الصفوف إزاء خطر الإخوان المسلمين” فتحول اللقاء إلى محاكمة للنظام عبّرت عن أصدق مشاعر السوريين ونقدهم لهذا النظام القمعي والفاسد والكاذب. وكان هناك من سجل كل مداخلات المثقفين سراً على “كاسيت”، وتم تداوله بين السوريين على نحو واسع.
المحطة الثانية أتت في أواخر الثمانينات عندما قرأت كتابا من ترجمته عن الديمقراطية الأوروبية. والمترجم هو مؤلف أيضا كما أعتقد ويعتقد كثيرون، ليس لأنه اختار وصاغ وقدم فحسب، بل في حالة ميشيل كيلو، كانت ترجماته جزءاً من مشروعه السياسي الذي كرس حياته كمثقف له. وقد شكل الكتاب منعطفا كبيرا في قناعاتي السياسية والفكرية، ونقلة باتجاه تجذير الوعي بالديمقراطية، التي كانت تنحصر عندي حينذاك بالحرية السياسة والانتخابات. بينما أدركت عبر هذا الكتاب أن الشعوب الأوروبية كانت قد توصلت إلى حكم نفسها بنفسها، عبر نضالاتها الطويلة وتضحياتها المتنوعة التي قادتها حركاتها السياسية والنقابية.
المحطة الثالثة كانت عندما رافقنا ميشيل كيلو في ربيع دمشق، فقد كان أحد المثقفين الأساسيين المساهمين بانطلاقه عبر بيان 99 مثقفا. ذلك الربيع الذي أطلقه المثقفون، ثم لحقت بهم وعلى نحو متأخر حطام الأحزاب ذات المفاصل المتيبسة، التي تبقت بعد عقود التصحير السياسي المنظم التي مرت على سوريا.
المحطة الرابعة من معرفتي به كانت في الثورة التي انحاز لها مباشرة وكان فرحاً بها كحلم تحقق بعد طول انتظار. كان ميشيل كيلو سورياً قبل كل انتماء آخر، ولم يكن هناك أية شبهة طائفية في سلوكه حتى ولو كانت بسيطة كالتي من الممكن أن نلحظها عند أغلبنا بحكم الوسط المحيط والتربية. فقد كان وسطه فعلا هو كل السوريين.
في أوائل أيام الثورة أعلن في اللقاءات التلفزيونية أن هذه الثورة ثورة شعب من أجل الديمقراطية، واستعمال المتظاهرين لكلمة الله أكبر لا يغير شيئا من هذه الحقيقة. وصار يكرر الله أكبر، الله أكبر.. تذكر كثير من السوريين حينذاك فارس الخوري عندما أعلن عن أولوية سوريته على منبر الجامع الأموي قائلا: إذا كان الاستعمار الفرنسي يقول إنه أتى إلى سوريا لحماية المسيحين من المسلمين، فأنا أرد عليهم من هنا بقولي: أشهد أن لا إله إلا الله.
أعتقد أنه يليق بميشيل كيلو تشبيهه بفارس الخوري كسياسي كبير، ولكنه يزيد عنه بأنه مثقف ولديه إنتاج صحفي وفكري. وإذا كنا نأخذ عليه أخطاءه، فنحن لا يمكننا أن نتكهن ماهي الممارسات الخاطئة التي كان من الممكن أن يقع بها هذا الرمز الوطني السوري الكبير، فارس الخوري فيما لو خاض السياسة في الرمال المتحركة السورية التي سادت بعد ثورة الحرية. وهذا ليس تبريرا للأخطاء بالمرة.
في اللقاء التأبيني الذي انعقد على نحو عفوي عند لحظة انتشار خبر وفاته على “الكلوب هاوس” دخل الشبيحة والذباب الإلكتروني فوراً، وعلى نحو بذيء، للتشويش على اللقاء. لم يكن ذلك غريبا فقد أوجع ميشيل كيلو النظام فعلاً، لأن انحيازه الحاسم للثورة منذ اللحظة الأولى كان كاشفاً مهماً لكذب النظام وادعاءاته بطائفية الثورة التي أطلقها منذ أول صرخة حرية في الشارع.
بالتأكيد الموت لا يجبّ أخطاء المتوفي، ولكن من لم يخطئ في السياسة السورية بعد الثورة فليرجمه بحجر. والرجم المعنوي طريقة سائدة في أجوائنا السورية الحالية من قبل الخطائين أولا. والرجم طريقة مذمومة على كل الأحوال وتزيد الطين بلة، حتى ولو كان ضد أعدائنا، فما بالك إذا كانت ضد أحد أعلام التاريخ السوري.
إن ما يليق بقامة ميشيل الكبيرة وبمكانته الكبيرة، هو محاولة دراسة ما أنتجه ميشيل كيلو من فكر وممارسات سياسية، دراسة علمية نقدية تستطيع الأجيال المقبلة الاستفادة منها. إن العمل على مثل هذا النقد ضمن حوارية معرفيه وموضوعية ونقدية مع إنتاجه وممارسته يمكن أن يغني الفكر السياسي السوري في المستقبل.
الميزة الأساسية لميشيل أنه لم يتوقف أبدا عن العمل من أجل حلمه في سوريا حرة وديمقراطية. وكان لديه دائما مبادرات جديدة على طريق هذا الحلم. ربما أخذ عليه كثيرون بأنه لم يستطع الاستمرار في مشاريعه التي بادر بها إلى النهاية. ولكن السؤال هنا يمكن أن يوجه إلى كل من يأخذ عليه هذا المأخذ المحق، لماذا لم تتابع أنت وتكمل إذا كانت لديك القدرة على المتابعة على عكس ميشيل كيلو؟ وهل من المفترض أن يكون ميشيل كيلو سوبرماننا كي ينجو من النقد؟ بالتأكيد هو بشر يصيب ويخطئ ونقده مشروع، ولكن يكفيه أنه كان لديه القدرة في كل مرحلة من المراحل السورية على إمساك الحلقة الأساسية التي ينبغي العمل عليها من أجل الديمقراطية في سوريا، وكان يطلق مبادراته في هذا الاتجاه.
أخيرا سأصل إلى الجانب الاستثنائي عند ميشيل كيلو وهو عمله الصحفي، إذ لم يغن أحد الصحافة السورية كما أغناها هو في عمره الصحفي الذي يزيد عن نصف قرن، فقد كان الأكثر موهبة بين الصحفيين. ولم يكن بارعا بالتقنيات الصحفية فحسب، بل كان بارعا في الوقت ذاته بقدرته على الوصول إلى كل الناس بكل مستوياتهم الثقافية والفكرية. كانت مادته الصحفية تعبر تماما عن شخصيته الاجتماعية الاستثنائية.
ميشيل كيلو استطاع أن يكسر الحاجز بين المثقف والناس. فقد جمع على نحو متوازٍ بين شخصية المثقف ثقافة واسعة، وبين الشخصية الشعبية ذات الكاريزما التي تشد كل مستمع له، وعبر طريقة صياغته لأفكاره، وطريقة كلامه، وحضوره القوي والآسر، كان يستطيع الوصول إلى قلوب كل الناس على تنوع مشاربهم.
————————–
وصية الراحل ميشيل كيلو.. ميثاق وطني موحد/ طلال المصطفى
كتب الراحل ميشيل كيلو، قبل وفاته بأيام، وهو في المشفى، وصيته الأخيرة إلى السوريين، وضمّنها معايير سياسية تصلح لأن تكون وثيقة وطنية للسوريين كافة، تحدد لهم بوصلة العمل السياسي في المستقبل.
جاءت “وصية” الراحل كيلو، تحمل خبرته الفكرية والسياسية الناتجة عن خمسة عقود من النضال الثقافي والسياسي ضد الاستبداد الأسدي، حيث عايش العمل السياسي السوري اليومي، وخاصة في مرحلة الثورة، من خلال انخراطه السياسي كمثقف عضوي (بحسب مفهوم الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي) يمثل حالة متقدمة في الوعي ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، ويعبّر عن الضمير الجمعي عن السوريين، بتعبير عالم الاجتماع الفرنسي أميل دوركايم.
هذا الوعي حمّله مسؤولية تاريخية في الإسهام الثقافي والسياسي الذي يخدم مشروع الثورة الديمقراطية في سورية، معبّرًا عن تطلعات السوريين وآمالهم في الحرية والخلاص من الاستبداد، بعيدًا عن أبراج النخب الثقافية والأدبية التقليدية، وينأى بنفسه عن ملذات العيش في كنف السلاطين والمُستبدين، فالثقافة -لدى الراحل كيلو- هي وظيفة اجتماعية تعمل على التغيير الذي يعكس تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن ثقافة الترف الفكري المحض.
انخرط الراحل كيلو في شؤون الثورة السورية 2011، منذ يومها الأول، باذلًا كلّ جهوده في توحيد السوريين في عمل سياسي موحد، يستند إلى معايير وطنية ديمقراطية، بعد كل انقسام سياسي يحصل في الأجسام السياسية السورية المعارضة للنظام الأسدي. واستنادًا إلى خبرته السياسية المعيشة في الواقع السوري لهواجس السوريين السياسية، في السنوات العشر الأخيرة من الثورة والحرب، جاءت وصيته الأخيرة قبل وفاته بأيام، وهي تصلح لأن تكون ميثاقًا وطنيًا للسوريين كافة، في الآتي:
1-دعوته إلى وحدة العمل السياسي السوري، من خلال خبرته المعيشة اليومية في تشظي المعارضة السياسية السورية في مرحلة الثورة والحرب، حيث عشرات الكيانات السياسية والمنصات المتنافرة التي يصدر أغلبها خطابات التشكيك وتخوين الآخر، لذلك جاءت دعوة الراحل كيلو إلى العمل الوطني السوري الموحد بعيدًا عن المصالح السياسية الحزبية والنخبوية، إذ خاطب السوريين: “لا تنظروا إلى مصالحكم الخاصة كمتعارضة مع المصلحة العامة، هي جزء أو يجب أن تكون جزءًا منها”. أي إن هناك ضرورة سياسية في الوقت الراهن، لإيجاد قواسم وطنية سورية مشتركة للخطابات السياسية السورية المعارضة كافة، مهما تنوعت وتعددت، تكون بوصلتها الوطنية تحرير سورية من النظام الاستبدادي وحلفائه.
2-دعوته إلى التمسك بقيم الحرية والديمقراطية ورفض الإقصاء، أي تبني مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، نظرية وممارسة، حيث ما زالت العديد من التيارات السياسية تشكو من تقلص أطر الممارسة الديمقراطية والرأي الآخر والحوار، في داخلها ومع الآخرين، وما اللغة التخوينية الشتائمية التي يمارسها بعض السوريين تجاه بعضهم البعض، ولم يسلم الراحل كيلو نفسه منها حتى بعد وفاته، إلا دليلٌ ملموسٌ على ذلك. لذلك جاءت دعوته بالتمسك بقيم الحرية في قوله: “لن يحرركم أي هدف آخر غير الحرية؛ فتمسكوا به في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخلوا عنه أبدًا، لأنه قاتل الاستبداد”.
التمسك بقيم الحرية والديمقراطية، بالنسبة إلى الراحل كيلو، يحصل في تشجيع الاتصال الديمقراطي داخل الأجسام السياسية السورية، وفي الوقت نفسه، في علاقاتها السياسية مع بعضها البعض، أي في الأشكال التحالفية التي يمكن تحقيقها بعيدًا عن الاختلافات الأيديولوجية، الدينية، القومية والسياسية باتجاه بناء مساحة وطنية مشتركة بين الجميع، من دون مغادرة أي طرف موقعه الأيديولوجي، القومي، الديني أو السياسي، أي ممارسة وإدارة الاختلاف، من خلال الإقرار بالتشابه والاختلاف على حد سواء، في العمل السياسي المشترك.
نعم، التمسك بقيم الحرية في أنساق المعارضة السورية، كما أوصى الراحل كيلو، هو ضرورة سورية وحاجة سياسية لجميع التيارات السياسية السورية، لفهم نفسها، وتوسيع المساحات المشتركة وبلورة أطر التفاهم المتبادل، وخلق أعراف وتقاليد حوارية بين أطراف المعارضة السورية، تبيّن في الممارسة السياسية أنها تفتقدها في الوقت الراهن.
3- دعوته إلى التمسك ببناء الدولة السورية الموحدة، والانتماء إليها فقط كهوية جامعة، بغض النظر عن الأيديولوجيات، الأديان، المذاهب، القوميات. إنها دولة المواطنة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والقانون بعيدًا عن الفئوية الطائفية والمذهبية، والتشديد على وحدة الأراضي السورية، كهدف سياسي استراتيجي، له الأولوية في نضالاتها السياسية وغيرها، فقد جاء في وصيته: “لا تنظروا إلى وطنكم من خلال أهوائكم وأيديولوجياتكم. انظروا إليهما من خلال وطنكم، فالتقوا بمن هو مختلف معكم، بعد أن كانت انحيازاتكم تجعله عدوًا لكم.. لن تقهروا الاستبداد منفردين. وإذا لم تتحدوا في إطار وطني وعلى كلمة سوا ء فسيذلكم إلى زمن طويل جدًا”.
4- دعوته إلى بلورة هوية سورية جامعة للسوريين كافة، بالاستناد إلى معايير سورية موحدة، من خلال ما جاء في وصيته: “كي تصبحوا شعبًا واحدًا، يا بنات شعبنا وأبناءه، اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا العقليات الضدّية، والثأرية، في النظر إلى بعضكم وإلى أنفسكم، فالمجتمعات لا تصبح مجتمعات وفقًا لذلك، وإنما هي تغدو مجتمعاتٍ حقًا بواسطة عقد اجتماعي، واضح، ومحدّد، وشفاف يساوي بين كل المواطنين إزاء الدولة وأمام القانون، ويكفل حقوقهم وحرّياتهم وكراماتهم. هذا ما حاول النظام الحؤول دونه طوال العقود الماضية، وهذا ما يجب أن نسعى إليه، أي التحوّل إلى دولة مواطنين، والتحوّل إلى مجتمع، أي إلى شعب حقًا، وبكل معنى الكلمة..».
هذا الانتماء إلى سورية يوجب العمل على بلورة مفهوم المواطنة، نظريًا وممارسة، في الأنساق الاجتماعية والسياسية السورية كافة؛ فالمواطنة عملية بنائية مستمرة، تتضمن مسؤوليات، حقوقًا، وواجبات، وهي جسر الوصول إلى مستوى متقدم من حالة الشعور والالتزام بكل مقتضيات الانتماء الوطني، وصولًا إلى المجتمع السوري الشامل الموحد بتنوعه القومي، الديني، المذهبي، الطائفي والسياسي. حيث جاء في وصيته: “اعتمدوا أسسًا صلبة وواضحة ومرنة للدولة، تستوعب الجميع، عربًا وكردًا وشركسًا وتركمانًا وأرمنًا، وكل الإثنيات والمكوّنات، تسيرون عليها، ولا تكون محلّ خلاف بينكم، وإن تباينت قراءاتها بالنسبة لكم، لأن استقرارها يضمن استقرار الدولة الذي سيتوقف عليه نجاح الثورة، أسسًا تقوم على الحرية والمواطنة المتساوية والديمقراطية، فهذا ما يكفل حقوق الجميع، والعدالة للجميع، لبناء سورية المستقبل”، أي ضرورة تبني القوى السياسية السوريةاستراتيجية بناء دولة القانون السورية المستقبلية (دولة المؤسسات القانونية والدستورية) صاحبة السيادة والقرارات المستقلة داخليًا وخارجيًا.
4- دعوته إلى عدم ارتهان العمل السياسي السوري للخارج، كما هو حاصل الآن، وعبّر عن ذلك بقوله: “لم تتمكّن ثورتنا من تحقيق أهدافها، بسبب مشكلات داخلية، وارتهانات خارجية. وقد دفع شعبنا أثمانًا باهظة طوال السنوات العشر الماضية. مع ذلك، فإن النظام، مع حليفيه الإيراني والروسي، لم ينتصر. فلنبق على تصميمنا، وعلى توقنا لاستعادة سوريتنا، بالخلاص من هذا النظام الذي صادر أكثر من نصف قرن من تاريخ بلدنا. شعبنا يستحق السلام والحرية والعدالة… سورية الأفضل والأجمل بانتظاركم”.
التصدي لكل محاولات الهيمنة الخارجية التي تستهدف وجود سورية كدولة، من خلال تعبئة طاقات السوريين بكل فئاتهم الشعبية في نضال طويل ومتعدد الأساليب والأدوات، على الصعد كافة، للدعوات التقسيمية العرقية والمذهبية الطائفية، من خلال الاعتماد على إيجاد المؤسسات السورية الديمقراطية التي تجمع السوريين كافة، للدفاع عن وحدة سورية الجغرافية، وفي الوقت نفسه الانفتاح على القوى العالمية (دول ومنظمات وأحزاب..) التي تساند الشعب السوري، في نضالاته بالخلاص من الاستبداد والاحتلالات، والاستفادة من تعددها واختلافاتها وتناقضاتها السياسية لصالح القضية السورية.
5- دعوته إلى التمسك بإسقاط نظام الاستبداد، كهدف استراتيجي، حيث قال: “يجب الخلاص من هذا النظام الذي صادر أكثر من نصف قرن من تاريخ بلدنا”، وقد ربَط إسقاط هذا النظام الاستبدادي ببقاء السوريين على الجغرافيا السورية، إذ قال: “لن تصبحوا شعبًا واحدًا، ما دام نظام الأسد باقيًا، وما دام يستطيع التلاعب بكم، بل إنكم ستبقون تدفعون أثمانًا إقليمية ودولية كبيرة في سبيل حريتكم، فلا تتردّدوا في حثّ الخطى من أجل الخلاص منه نهائيًا، ويأتي في مقدمة ذلك الوحدة، لعزل هذا النظام والتخلص منه نهائيًا”.
6- دعوته إلى الاهتمام بالمرأة السورية والشباب، وإلى عدم إقصائهم من العمل السياسي السوري، حيث المشاركة الفعالة والشجاعة للمرأة والشباب في الثورة السورية 2011، إذ كتبالراحل: “تستحق المرأة السورية الرائعة والشجاعة والصابرة كل التقدير والعرفان، فهي التي أعطت للثورة السورية طابعها الخاص والمتميز، منذ بداياتها، وقدّمت كل ما يمكنها، من تضحياتٍ وبطولاتٍ. لذا لا يمكن أن نبني سورية الجديدة دون مكانة طبيعية للمرأة السورية، تضمن حقوقها ومكانتها السامية في المجتمع، هذا أقل تقدير لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، فهم عنوان للحياة والكرامة. تحية لشباب سورية الشجعان الذين كسروا هيبة النظام بمظاهراتهم الجريئة التي واجهت هراوات الشبّيحة ورصاص أجهزة الأمن في مظاهراتهم السلمية، في امتداد مدن سورية وبلداتها وقراها، وكل المحبة للأطفال أبنائنا الذين حُرموا من طفولتهم، ومن طمأنينتهم، فهذا ما حاولناه من أجل مستقبل أفضل لهم”.
7- دعوته إلى فكرة أنّ النضال من أجل الحرية والخلاص من الاستبداد لا ينفصل عن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان، فالحرية واحدة للشعوب كافة، لذا أوصى كيلو السوريين في نضالهم ضد الاستبداد السوري بألا يسهوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، في نضاله التحرري ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الجولان المحتل: “لا تنسوا يومًا أن قضية فلسطين هي جزء من قضايانا الأساسية، ففلسطين قضية حرية وكرامة وعدالة، وقضية شعبنا، أيضًا، كذلك، وتلك القيم السامية لا تتجزأ. كفاحنا مع شعب فلسطين جزءٌ من كفاحنا ضد الاستبداد، وبالعكس. ولتبق قضية استعادة الجولان في مقدّمة أجندتنا الوطنية”.
8- دعوته إلى الإنصات للمثقفين السياسيين الملتصقين بالقضايا الوطنية السورية، فمن المعروف أن انطلاقة الثورة السورية كانت من كل الفئات الاجتماعية والمهنية، ولكن هناك ضرورة لقيادتها وتوجيهها نحو الوجهة الوطنية الصحيحة، من قبل السياسيين والمثقفين العضويين المشهود لهم بخبرتهم ونضالهم التاريخي ضد هذا النظام، لذلك تضمنت وصيته الاعتماد على أصحاب المعرفة والفكر: «لا تتخلوا عن أهل المعرفة والفكر والموقف. ولديكم منهم كنز، اسمعوا إليهم وخذوا بما يقترحونه ولا تستخفوا بفكر مجرب فهو جزء من زادكم، وثروتكم الرمزية، وجزء من تاريخكم”.
أخيرًا، تحضر أهمية “وصية” الراحل كيلو، المثقف العضوي وضمير السوريين بامتياز، وهي تتضمن المعايير الوطنية الرئيسة التي تصل إلى إمكانية تسميتها بالميثاق الوطني الموحد للسوريين، في مرحلةٍ من التشظي والانقسامات السورية المركبة (العرقية، المذهبية والسياسية في صفوف السوريين كافة، بالإضافة إلى التدمير المادي، الاجتماعي، الثقافي والسياسي، بيد هذا النظام الاستبدادي الذي يحكم بالحديد والنار منذ خمسة عقود، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة من الثورة والحرب المركبة؛ فهل ينصت السوريون إلى وصية الراحل كيلو، وهو الناطق والمعبّر الحقيقي عن معاناتهم وصبرهم الثقيل، طوال عمره النضالي حتى قبل لحظات من وفاته؟
مركز حرمون
———————–
الكاتب “سعد فنصة” يروي قصة “ميشيل كيلو” ووساطة “اللواء خير بيك“
قال الكاتب والمصور “سعد فنصة” إنه يحتفظ بشريط كاسيت يظهر جرأة وشجاعة الكاتب والمفكر الراحل “ميشيل كيلو” الذي رحل في باريس منذ أيام.
ووقف كيلو مبكراً في وجه مهرجي قيادات البعث الاشتراكي المنتفع من بيع الشعارات، خلال مؤتمر للكتاب والصحفيين السوريين عقد بدمشق نهاية العام 1979، وقال بالحرف بحسب التسجيل: “يلح لدي سؤال أوجهُهُ اليكم: هل قضية الاشتراكية في وعي الجماهير مسألة تتقدم أم تتراجع..؟
وأردف “برأيي، إنها مسألة تتراجع..ويستطيع أي مسؤول منكم زيارة أي فرن وباص ومدرسة..ليجد أن هذه القضية تتراجع..كذلك قضايا الأمة”.
وتابع “كيلو” متسائلاً: “عن ماذا أحدثكم في الاقتصاد ..عن الزراعة المتدهورة …أم الصناعة التابعة..”.
وكان الشاعر السوري الراحل “ممدوح عدوان” حاضراً في الاجتماع أيضاً وتحدث بجرأة لم تقل عن جرأة “كيلو”، حيث تساءل حينها عن طبيعة “سرايا الدفاع” وسلطتها وما سر امتيازاتها حتى أن جندياً في هذه السرايا يتمتع بامتيازات ونفوذ أكثر من ضابط في جيش النظام فهيمن على الصالة خوف شديد حيال هذه الجرأة، تجاه الميليشيا التي كانت ترعب السوريين بقيادة “رفعت الأسد” كان تمسك البلاد بالنار والبارود آنذاك.
وبعد أسابيع قليلة تم اعتقال المعارض الراحل في تشرين الأول/أكتوبر/1980 من قِبَل فرع المنطقة للأمن العسكري في دمشق (فرع العدوي) على خلفية انتمائه للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب في أحد فروع المخابرات وهي المرة الأولى التي يتم اعتقاله فيها.
وروى “فنصة” لـ”زمان الوصل” أن كيلو اعتقل ثانية عام 2006 علي خلفية توقيعه بيان المثقفين السوريين واللبنانيين وحكمت عليه المحكمة العسكرية عام 2007 بالسجن ثلاثة أعوام وتم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته.
ونوّه “فنصة” إلى أنه كان على علاقة صداقة مع دكتور يدعى “عبد الحميد الحسن” يدرّس في كلية الفلسفة بجامعة دمشق، وكان بدوره على علاقة صداقة مع اللواء “فؤاد خير بيك” وهو ابن شقيق محمد ناصيف خير بيك أحد رموز النظام ومن المقربين لحافظ الأسد.
وأضاف محدثنا أنه طلب من “الحسن” حينها أن يتوسط لدى “خير بيك” الذي كان مديراً للأمن الداخلي للإفراج عن “ميشيل كيلو”، وفعلاً تحدث “الحسن” مع “خير بيك” بهذا الشأن ففوجئ بقوله إن أمر “كيلو” خارج إرادته وقرار اعتقاله رئاسي.
وكشف مؤسس ومالك “دار واشنطن الدولية للنشر” أنه تعرف على “كيلو” بشكل غير مباشر منذ أن كان في الصف التاسع من خلال مداخلاته ومقالاته الفكرية ومواقفه وحواراته، واحتفظ منذ ذلك الوقت بتسجيل طويل ونادر يتضمن جانباً من هذا النشاط مع الشاعر الراحل “ممدوح عدوان”.
وقضى “كيلو” -حسب محدثنا- نصف قرن من عمره في الدفاع عن قضية الحرية في سوريا لذلك تبدى الحس الشعبي في الاحتفاء به بعد موته، مضيفاً أن هذا الحس غالباً يكون سليماً وعفوياً لا تشوبه شائبة بخصوص من يمتص دم الشعب ومن يدافع عن روحه وحريته وكرامته، ومن يدفع الأثمان لذلك -حسب قوله- جاء هذا الاهتمام الشديد بقامة وطنية وفكرية كـ”ميشيل كيلو” الذي كان فوق الأديان والطائفية والحزبية والمذاهب، وفوق الشوفينية التي يتمسك بها بعض الناس ويدافعون عنها، إن كانت شوفينية دينية أو حزبية أو مذهبية.
وهذا الاهتمام بـ”كيلو” يوحي -كما يقول- بحقيقة الشعب السوري المنتمي لهويته الوطنية والذي يجمعه الانتماء الوطني قبل أي اعتبارات أخرى ولا يمكن أن يكون لسوريا مستقبل قادم دون تكريس هذه الهوية الجامعة.
وروى “فنصة” أنه التقى “كيلو” عام 2010 بعد الإفراج عنه وكان حينها على موعد مع المخرج “ريمون بطرس” للاتفاق على إنجاز فيلم وثائقي عن تدمر، فجاء إلى المقهى ليجتمع بأصدقائه، وعرف منه تفاصيل عن اعتقاله المريح نوعاً ما، حيث لم يتعرض للتعذيب حينها لأن النظام لم يجرؤ على ممارسة التعذيب بحق “كيلو” نظراً لأن المجتمع الدولي كان يراقب اعتقاله باعتبار أنه سجين رأي.
وبعد خروجه من سوريا كتب “فنصة” مقالة فور وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه القصة على صفحته الشخصية في “فيسبوك” عن هذه القصة، وبعد نشر المقالة -كما يقول- استنفرت مخابرات النظام حيث وصلت إلى اللواء “خير بيك” وذهب عناصر المخابرات إلى مكان عمل زوجته في دمشق وإلى مكان عمله السابق في متحف دمشق للسؤال عن كيفية مغادرته لسوريا وخلفيته السياسية.
وكشف “فنصة” أن الراحل “ميشيل كيلو” لم يكن يصطدم مع السلطة الأمنية والدليل على ذلك هي شهادة اللواء “فؤاد خير بيك” أن موضوع اعتقال “كيلو” خارج إرادته ولا يستطيع مساعدته وأن قرار اعتقاله من الأب والابن مباشرة، حيث كان مزعجاً لكليهما، وكانت أحاديث “كيلو” ومحاضراته -حسب قوله- تتضمن آراء سياسية واقتصادية جريئة تخص بنية النظام وسياسة الفساد والنهب واللصوصية التي تنخره من الداخل، وكذلك مسألة التخبط في المواقف الدولية، فكان “كيلو” رجل فكر وليس مجرد معارض أو في نيته الاصطدام مع الأجهزة الأمنية بشكل مباشر.
وأردف المصدر أن الكثير من رموز الأجهزة الأمنية في سوريا كانوا يعرفون قيمة “كيلو”، وأنه يكتب بقلم وطني وليس مأجوراً أو مرتهناً لأي جهة داخلية أو خارجية، وكان من المريب أن يتم فتح أبواب السجون لشخصيات سلفية متطرفة لتمر بأجندتها وأسلحتها وأفكارها في الوقت الذي يتم سجن مفكر تنويري وطني مثل “ميشيل كيلو”، وهذا ما يؤكد مدى ظلامية هذا النظام.
فارس الرفاعي – زمان الوصل
—————————-
ميشيل كيلو الذي دافع عنا يوم خذَلَنا معارضون/ ماهر اسبر
في نهاية العام 2005، كنت وطارق غوراني، وما عُرف باسم “تجمع شباب من أجل سوريا” المختصر بـ”شمس”، مطاردين من طرف أجهزة الأمن السورية، إذ داهمت جميع الأجهزة بيوتنا، الأمن السياسي، فالأمن العسكري، فأمن الدولة، حتى وصلت القضية في النهاية إلى المخابرات الجوية.
راح الأشخاص، البعيدون عن عالم السياسة والمعارضة والذين لا يعرفون شيئًا عن نشاطنا، ينسجون قصصًا عن ارتباطنا بتنظيمات إسلامية ومؤامرات، وعن علاقاتنا بأحلاف دولية وتدخلات خارجية وغيرها. نُسِجَت عنا قصص لا يعلم بها إلا الله، خصوصاً أنها كانت فترة قلاقل كبيرة، إذ كان النظام السوري مهدَّداً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ووجود الأميركيين في العراق.
بدأت غالبية الوسط المعارض الذي استشعر الخطر من معرفته بنا، بسبب مشاركتنا معه سابقاً في نشاط ما، كاعتصام أو منتدى أو ربما بسبب جلسة في مقهى الروضة، بالتنصل منا بسبب خوفه من هذه الهجمة المخابراتية. وكان لزاماً على هذا الوسط المنسحب، تبرير ضعفه وتخاذله بأن يلقي اللوم علينا، وبدأت تتوالى علينا الانتقادات من هذا الوسط، تارةً بسبب ما سمعه من كلام أشاعته المخابرات قاصدةً، وتارة أخرى بسبب أقوال الناس العاديين وخيالاتهم، خصوصاً أنه في حينها لم يبق تلفزيون أو وسيلة إعلامية إلا وذكر أخبار الاعتقالات والمداهمات التي تحصل لنا، ولم تبق منظمة دولية وحقوقية إلا وطالبت بنا.
عانيتُ شخصياً في فترة ملاحقتي التي استمرت حوالى 11 شهراً، مما هو أشد من اعتقالي، وهذه ليست مبالغة أو تقليلًا من شأن ما تعرضت له في المعتقل، بل بسبب مرارة خذلان “رفاق درب” والأصدقاء أحياناً.
يومها، فقدتُ الاتصال بكل شخص أعرفه في حياتي، تركت منزل أهلي وجميع أقاربي وأصدقائي المقربين، من دون أي اتصال بهم بسبب مراقبة الأمن الحثيثة لهم، وبسبب الاستدعاءات والمداهمات التي تعرضوا لها مرات عديدة. ضاقت بي السبل في بعض الأيام، فكنت أنام في إحدى دور السينما نهاراً وأخرج ليلاً، أتنقل بين الشوارع والمقاهي حتى صباح اليوم التالي، وأسمّر عينيّ في كل سيارة أو دورية راجلة.
أذكر أننا كنا، وطارق وأنا، عائدين ذات مرة من حلب بعد لقاء مع محمد عرب وحسن قاسم ومجموعة من الشباب، ووصلنا إلى دمشق في وقت متأخر ليلاً، وكان طارق قد عثر على مكان لينام فيه في مكتب كريم عربجي، أما أنا فكنت أؤمل نفسي في مكان لدى صديق آخر. اتصلت بالصديق مرات عديدة، لكنه لم يجب، فضاقت بي السبل، وبتّ ليلتها متكوراً على نفسي تحت شجرة في حديقة عامة وكان الطقس شتائياً.
التقيت في تلك الأيام مع فائق المير أسعد، في مدينة القدموس، برفقة أيهم وكريم صقر ومجموعة من السياسيين والناشطين. “العميم” الذي كان ملاحقاً أيضاً، بسبب قراءته لكلمة إعلان دمشق في تأبين جورج حاوي، نصحنا يومها أن نلتقي بميشيل كيلو. عدت بعدها إلى دمشق واتصلنا بميشيل، أنا وطارق غوراني، ولم نخبره سوى أننا من طرف “العميم” وحددنا موعدًا معه في مقهى الروضة.
تأخرتُ نصف ساعة على الموعد، وعندما وصلتُ، كان غاضباً وهو لا يعلم مَن سيلتقي أو ما هو الموضوع، عندما رآنا تغيرت ملامحه وتفهَّم مباشرة وانفرجت أساريره، بل نسي أنني تأخرت عليه، وكان قد سمع الكثير من الروايات عما يحدث معنا، لكنه بسبب خبرته الكبيرة ورؤيته الثاقبة كان قد وصل إلى جوهر القصة الحقيقية من دون أن نشرح له ذلك سابقاً، واستطاع أن “يفلتر” الكثير من الملوثات والاشاعات التي أحاطت بنا وبقصتنا. كان فهم أننا مجموعة من الشباب الصغار بالسن “كان متوسط أعمارنا 23-24 سنة”، يسعون لتكون سوريا بلداً حراً وديموقراطياً. بعدها التقيناه أنا وطارق أربع أو خمس مرات، في هذه اللقاءات كنا نمشي لساعات في دمشق القديمة والقصاع، فنحن لا نستطيع الجلوس في مكان عام.
وكان يمشي معنا، رغم كبر سنه وضخامة جسمه، وصعوبة التقاطه أنفاسه أثناء السير. ومع ذلك، حاول ألا يُشعرنا بأنه متعب، وراح يراقب المفارق والطرق كلما وصلنا إلى رأس شارع، وكأننا في معركة وهو يغطينا نارياً. وكثيراً ما عرض علينا تأمين مبيت لنا، وحاول بإصرار إعطاءنا نقوداً. في إحدى المرات، أصرّ كثيراً على إعطائنا النقود، حتى كاد يتعارك معنا، وحين رفضنا أخذها، أعادها إلى جيبه مكسور الخاطر بشكل حقيقي، إذ لم يكن موقفه معنا موقف مجاملة، بل شعر بمسؤولية الأب والقريب وبالواجب “الحزبي أو الرفاقي”، وكأنه المسؤول عنا، رغم أنه لم يكن هناك أي رابط تنظيمي بيننا سوى أننا نواجه النظام ذاته.
في إحدى المرات قال لنا بعدما وقف في رأس أحد أزقة دمشق القديمة، وبعدما علم منا بتفاصيل ما قمنا به وعملنا عليه في السابق، قال: “أنتم ثاني أهم شيء حصل في سوريا بعد إعلان دمشق”، ثم قال ممازحاً “اسمحوا لي أن أجعل الأول من نصيب إعلان دمشق كنوع من الأنانية، فأنا الذي أسسته”، وضحك. قوّى ميشيل معنوياتنا ورفع منها بشكل حقيقي، أنصفنا بوصفه واقع ما رآه من عملنا في حينها من دون أن يبخسنا حقنا أو أن يبالغ في الوصف، الأمر الذي جعلني أنا وطارق وبقية المجموعة أكثر قدرة على مواجهة الظروف والمشقات طوال فترة الملاحقة، ومن ثم فترة الاعتقال، وحتى هذه اللحظة.
عندما خُذلنا شخصياً وفكرياً من طرف العديد من المعارضين، كان هو واحداً من القلائل الذين دعمونا، بل وكان أكثرهم دعماً ومساعدةً لنا، حتى كاد يتأذى بشكل فعلي من احتكاكه بنا في تلك الفترة. قد يكون الشخص الوحيد الذي تحمل مسؤولية الدفاع الفعلي عنا وعن أمثالنا، هو ميشيل كيلو، الرجل الذي عجن حياته بمبادئه وعبّر بشجاعة إنسانية طوال حياته الطويلة، وحتى النفَس الأخير، عن مواقف عديدة لم يسبقه إليها أحد، ولا فضل لأحد عليّ كفضله.
المدن
بعض من سيرة ميشيل كيلو مع “المعارضة السورية”/ ماجد كيالي
بداية فقد وضعت كلمتي “المعارضة السورية” بين مزدوجين، كنوع من تحفّظ، أو بهدف التوضيح، لأن تلك التسمية هي دلالة على أجسام عديدة واسعة، إذ لا تقتصر على ما يسمى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، أي الجهة التي تحتكر تمثيل المعارضة رسميا والتي تأسّست بمداخلات إقليمية، وليس نتيجة لحراكات قوى المعارضة السورية التاريخية والمعروفة، والتي باتت تحرص على تغطية مداخلات تركيا وتمثل مصالحها في الشأن السوري، أكثر بكثير ممّا تحرص على سلامة مسار ثورة السوريين وتمثل مصالحهم.
التوضيح يتعلق أيضا بغياب كيان سياسي جامع يمثل المعارضة الحقيقية التي تمثل مصالح أغلبية السوريين، ذلك أن النظام الذي حكم البلد لأكثر من نصف قرن (في عهد الأسدين)، احتكر السياسة وصادر الحريات وحرم الأحزاب السياسية (إلا ما تم تدجينه في ما يسمى الجبهة الوطنية التقدمية)، لذا فقد كان من الطبيعي أن افتقاد الحراكات الشعبية السورية لقيادة أو لكيان سياسي جامع ومجرّب يعبّر عنها ويمثلها ويدير كفاحها من أجل التغيير نحو دولة المؤسسات والقانون وحقوق المواطنة والنظام الديمقراطي.
وعليه، فقد يمكننا تفسير المكانة المتميزة التي استحقها ميشيل كيلو الإنسان والمثقف والمناضل الذي غادر الدنيا قبل أيام، في المشفى في منفاه الفرنسي، إذ ثمة كثر لا يدركون بأن هذا الرجل لم يتبوأ أيّ مكانة قيادية في الكيانات السورية المعارضة، ولا كان مقرراً في مساراتها أو خياراتها. وضمن ذلك فهو لم يكن في تشكيلة المجلس الوطني السوري الذي تشكل كقيادة للمعارضة (أواخر 2011)، ولم ينضو في “الائتلاف الوطني” الذي خلف الكيان السابق (أواخر 2012) إلا في ما يسمى “التوسعة” (صيف 2013)، ولكنه بعد ثلاثة أعوام قدم استقالته منه، بعد أن يئس من إمكانية إصلاحه، وعبّر عن ذلك علنا في وثيقة أصدرها مع مجموعة من رفاقه (أواخر العام 2016) عنوانها “نداء إلى شعبنا السوري.. وجهة نظر نقدية لتصحيح مسارات الثورة السورية…”، وقّع عليها المئات.
ففي تلك الوثيقة التي توضّح مواقف ميشيل كيلو تم التأكيد على ضرورة “قطع” المعارضة السورية “مع عديد من الأوهام والمراهنات الخطأ.. بشجاعة أخلاقية وبمسؤولية وطنية..”، والتي تمثلت أولاً في “التعويل على الخارج والارتهان لأجنداته بدل التعويل على إمكانيات شعبنا، ووضع أولوياته وحاجاته فوق كل اعتبار. وتصعيد العمل المسلح بطريقة غير محسوبة أو مدروسة”. ثانياً، “شيوع وهم مفاده أن إسقاط النظام لن يتم إلا بالسلاح وحده مع تأكيد أن الدفع في اتجاه العسكرة أي تشكيل بعض الدول لفصائل عسكرية، رغم أن النظام يتحمّل المسؤولية الأساسية عن ذلك، جاء نتيجة “التلاعبات الخارجية بالثورة للسيطرة عليها والتحكم بتداعياتها وفرض أجندة معينة على خطاباتها وأشكال عملها مما أضر بها وبصدقيتها، كما أضر بشعبنا.. فالدول ليست جمعيات خيرية، وهي تعمل لأجندتها ومصالحها، وكان الأجدى للثورة أن تشق مسارها وأشكال كفاحها حسب إمكانيات شعبها..”. ثالثاً، وهم المراهنة على “جبهة النصرة (فتح الشام لاحقاً) وأخواتها، إذ أن هذا الفصيل الذي نشأ بشكل مريب.. نتيجة لتلاعبات خارجية، وهو لم يحسب نفسه يوما على الثورة، بل إنه ناهض مقاصدها علناً، براياته وخطاباته ونمط تعامله مع البيئات الشعبية.. الأمر الذي خدم النظام..”
بيد أن كيلو بعد هذه المواقف وتلك الاستقالة لم يعتكف في منزله ولم ينح نحو التنظير، إذ ظل مصمما على مواصلة طريقه بحيوية عالية عبر الكتابة وبث الرسائل الصوتية، وعبر التواصل مع قطاع واسع من المعارف رغم سنه المتقدمة (81 عاما).
هكذا، استحق ميشيل كيلو مكانته المتميزة كعلم من أعلام المعارضة السورية وكمثقف شجاع وكمفكر نقدي يستعصي على الغياب، بحيث بات قبلة كثيرين داخل سوريا وخارجها، وعلى الصعيدين الشعبي والرسمي كصاحب رأي حر، وقد اشتهر بإطلالاته التلفزيونية بالذكاء السياسي وسرعة بديهة، مع صوت جهوري يتميز به، وبلهجته الشامية واللاذقانية. والأهم من كل ذلك أنه كشخصية معارضة برز نجمه في عهد حافظ الأسد، لاسيما في كلمته المتميزة والجريئة في ندوة كان نظمها النظام للاطلاع على رأي المثقفين في مقر اتحاد الكتاب العرب (1979)، التي تحولت إلى ندوة لمحاكمة النظام أو لفضحه؛ وهو الأمر الذي دفع ثمنه سجنا لقرابة عام ونصف العام، أول مرة (عهد الأسد الأب)، وفي المرة الثانية سجنا لثلاثة أعوام (عهد الأسد الابن).
إضافة إلى جرأته في مواجهة السلطة تميز كيلو بالبساطة والتواضع مع الآخرين، سواء الذين يعرفهم أو لا يعرفهم، كما تميز عن المثقفين الآخرين بالانخراط، من الناحية العملية، في العمل السياسي، وإن من خارج الأحزاب، إذ كان غالبا المباد أو أحد المبادرين، إلى خلق منابر للمعارضة، مثل بيان المئة، أو بيان الألف، أو بيان بيروت ـ دمشق، أو لجان إحياء المجتمع المدني (2000 ـ 2005)، ناهيك أنه لم يكف يوما عن الكتابة حتى يومه الأخير.
والمعنى من كلّ ما تقدم أن كيلو كان يشكل قيمة رمزية بحد ذاته، إذ أنه صنع نفسه وصنع تاريخه ومنبع قوّته يكمن في قيمه وجرأته واستقامته واستقلاليته وتصميمه على الكفاح من أجل استعادة شعبه لحريته وكرامته.
رحل ميشيل كيلو عن عمر 81 عاما والقضية السورية تزداد تعقيدا بعد أن باتت سوريا مكانا للتصارع الإقليمي والدولي، وبرحيله فقد الشعب السوري واحدا من أهم أعلامه ومن أهم صناع تاريخه الحديث، لاسيما تاريخ التمرد على نظام الأسد، وفقدت بذلك المعارضة رمزها المعنوي الأهم، وربما الأكثر شهرة وشعبية وثقافة ونبلاً.
العرب
======================
تحديث 24 نيسان 2021
————————–
السيد الرئيس ميشيل كيلو/ عمر قدور
برحيله حظي ميشيل كيلو بما لم تنله شخصية معارِضة أخرى من إبداء الحب والاحترام، أو التعاطف في الحد الأدنى. البعض شبّه الحفاوة به على وسائل التواصل الاجتماعي بالاقتراع، وكأن المعارضين على اختلاف توجهاتهم انتخبوه رئيساً في وقت يتهيأ فيه بشار الأسد ليقترع لنفسه، بقوة حلفائه وعسكره ومخابراته وشبيحته.
صار في وسعنا التمييز بين مبالغات السوريين المدفوعة بفكرة الفقدان وبين الحفاوة المدفوعة بحضور صاحبها في وجدانهم؛ المبالغات يمكن فهمها على أرضية المزاج الجنائزي السائد الذي يتوّج الخسائر الخاصة والعامة في العقد الأخير، بينما تأتي تلك الحفاوة تحصيلاً عفوياً لمكانة المحتفى به. رأينا، على سبيل المثال، ذلك الاحتفاء المستحق بمي سكاف وبعبد الباسط الساروت.. وأخيراً بميشيل كيلو، من دون أن نبخس راحلين آخرين حقهم من اهتمام لم يحظوا به.
أثناء حياته، تعرّض ميشيل كيلو للكثير من النقد، وبعض أصحاب الانتقادات هم ممن إنبروا لتعداد مزاياه لمناسبة رحيله. ما يرونه مزايا لم يُخترع للتو، هي مواقف أو توجهات فكرية موجودة لديه من قبل، وبناء عليها نشأت علاقة الاشتباك معه، لا الانقطاع الذي يعني ضمناً الانقطاع عن النقد أيضاً. هناك طيف واسع من المعارضين يرى في مواقف وتوجهات ميشيل كيلو ما يتفق معه، مثلما يرى ما يختلف معه، وأفراد هذا الطيف مختلفون في ما يتفقون معه فيه وفي ما يختلفون.
بعبارة أخرى، هناك شراكة ممكنة مع الراحل، تختلف نسبتها بين شريك وآخر، ويتعذر أن تبلغ حد التطابق لأن ميشيل كيلو نفسه لم يكن واحداً منسجماً في أفكاره وتوجهاته. هذه الشراكة تعني الكثير في ميدان السياسة، وهو متحرك بطبيعته، وقابل أيضاً للتجريب وللخطأ والصواب بمفهومهما النسبي، من دون أن تُبتذل النسبية إلى نسبوية تبرر كافة الأخطاء أو الخطايا.
الهجوم الشرس لأبواق الأسد على الراحل، عطفاً على احتفاء المعارضين به، يوضّح أيضاً مكانته، ويفضح مقدار ما كان وجوده يؤذيهم ويؤذي سادتهم. هم يعرفون جيداً أن اتهاماتهم النمطية الموجهة إلى معارضين آخرين لا مكان لها للنيل منه، إذ يتعذر مثلاً اتهامه بأول التهم الجاهزة، أي بالطائفية، ويتعذر اتهامه بتلك الاتهامات الموجهة إلى ما يسمونها “المعارضة الخارجية”، فتجربة الرجل مع الأخيرة تنظيمياً قصيرة، وهو لم يستمد منها أية قيمة، بل على العكس كان وجوده العابر فيها انتقاصاً من رصيده.
لعل الهجوم الوحيد الآخر على الراحل، الذي نستطيع الإشارة إليه كظاهرة، أتى من الأكراد على خلفية أقوال له ترفض ما يراها “توجهات انفصالية كردية”. ومع عدم استبعاد سوء الفهم أو غيابه لدى بعض المشاركين في الهجوم، لا بد من التنويه بتوجه كردي سائد يعمل أصحابه في كل مناسبة على تأكيد القطع بين الأكراد وعموم السوريين. هنا تصبح حفاوة معظم المعارضين السوريين بالراحل مدعاة للتمايز الكردي وإظهار الانفصال التام بين الجانبين، ومن طرف خفي إظهار تلك الحفاوة كأنها حفاوة بشخص معادٍ للأكراد ولأنه معادٍ لهم لا لاعتبارات متعددة أخرى من المرجح ألا تكون بينها المسألة الكردية على الإطلاق.
كان ميشيل كيلو قد انتهى إلى الإيمان بفكرة المواطنة المتساوية ضمن مشروع للتحول الديموقراطي في سوريا، وربما لم يتخلص نهائياً من آثار الفكر القومي الذي امتزج يوماً مع يساريته التي طغت عليها، إلا أنه “مع هذه البقايا” قد يشترك مع كثر “من عرب أو أكراد” يعتنقون الفكر القومي بأشد مما اعتنقه يوماً. ضمن تصوره عن المواطنة، كان قد شارك في إعداد بيانات تؤكد على الاعتراف بالخصوصية القومية للأكراد، وهو في أسوأ الأحوال صاحب رأي لا يحمل سلاحاً ليحكم الرقاب به، ولا يحلم بحمله.
مكانة كيلو وإرثه الشخصي توليا إسكات إسلاميين تعلو أصواتهم عادة من بوابة عدم جواز الترحم على غير المسلم، هذه الأصوات بقيت قليلة ونشازاً هذه المرة، وكانت قد توارت إلى حد كبير أيضاً عند رحيل مي سكاف. في المقابل، قد يروق لقلةٍ النيلُ من ميشيل كيلو من هذه الزاوية، أي لإحجام الإسلاميين عن مهاجمته وأخذه دليلاً على تملقه إياهم، إلا أن هذه الأصوات كانت ضعيفة بقدر ضعف نظيرتها الإسلامية، ما يشجع على الظن بأن أصوات الجانبين تتحين غياب الحد الأدنى من الاتفاق بين من يمكن وصفهم بشرائح أوسع لا يغلب عليها التعصب الأيديولوجي الإقصائي بطبيعته.
لقد كان ميشيل كيلو بالمقارنة مع المعارضين الأقرب إلى المحتفين به، فهو كان واضحاً وعلنياً بـ”أخطائه”، مثلما كان واضحاً في ما يُحسب له. كان دائم الحضور، ودائم الحيوية التي لا توحي إطلاقاً بأن صاحبها ثمانيني. ثمة شأن آخر متصل بحيويته، هو عدم ركونه إلى اليأس حتى من أولئك الذين اختبر العمل ومتاعبه معهم، وعدم اليأس من ذاته التي اختبرها في العمل العام. هذا العناد سيظهر مفارقاً للواقع البائس الحالي، إلى درجة يصعب الإيمان معها بأن ذلك البؤس قد لا يُشفى إلا بمزيد من العناد.
قد يُظن أن من أوجه البؤس الاقتراع لميشيل كيلو إثر رحيله، خاصة من قبل الذين اشتبكوا معه واختلفوا سياسياً بشراسة أثناء حياته. إنه قول يتكرر تحسّراً على عدم تكريم من يستحقون التكريم وهم أحياء، لكنه ظنّ ينتمي إلى المشاعر لا إلى السياسة، ففي الأخيرة لا بد من الاشتباك والاختلاف مع الأحياء، بل إن الحق في الاختلاف معهم من أسس المطالب الديموقراطية التي ينادي بها السوريون والتي نادى بها ميشيل كيلو وغيره من الراحلين.
إذا أخذنا فكرة الاقتراع لميشيل كيلو برمزيتها فهي تصلح كمؤشر إيجابي في وقت تتضاءل فيه إيجابيات الفضاء العام السوري، ففي الاقتراع له قبول بذاك المختلف، ذاك الذي ينال رضى نسبياً فلا يروق لنا كما نشتهي، أو كما كان يشتهي. إنه تمرين غير متعمد على الديموقراطية يُنتخب فيه رؤساء راحلون، في انتظار أن تأذن الظروف بانتخاب الأحياء.
المدن
————————
في غياب ميشيل كيلو.. عندما يفقد التديّن إنسانيته!/ أحمد الرمح
مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تم استدعائي والدكتور أحمد طعمة والشيخ رياض درار، إلى دمشق، وبعد احتجازنا يومًا في مكان لا نعرفه، أخذونا إلى قيادة الأركان، وهناك كان اللقاء مع العماد آصف شوكت، دام اللقاء ثلاث ساعات ونصف، انتهى بطرحٍ من آصف شوكت: “رشّحوا لنا شخصية معارضة لتقود حكومة وحدة وطنية”. ومن دون تردد أو اتفاق، نطقنا الثلاثة بصوت واحد: “ميشيل كيلو”. قال: “كيف ترشحون مسيحيًا وأنتم إسلاميون”؟ قلنا: “نحن سوريون، قبل أن نكون إسلاميين”. وأخذ يتهم ميشيل باتهامات عدة، كنا نراها أوسمة تزين سيرة فارس الحرية ميشيل كيلو. هذا عن ميشيل، كيف نراه كبيرًا ورمزًا يمثّلنا.
منذ أشهر، تم إلقاء القبض على رجل سوري في مطار باريس، دخل فرنسا بجواز سفر مزور، وكان الرجل معرضًا للسجن والترحيل، فاستنجد بميشيل كيلو، ولم يطلع النهار حتى حوّل الأستاذ ميشيل هذا الرجلَ من متهم مهدد بالسجن إلى لاجئ سياسي يتمتع بحماية فرنسا، هذا هو ميشيل السوري النبيل والإنسان، وما بين ميشيل الرمز الكبير والإنسان، يحاول غلمان التدين الموازي الإساءة إليه باسم الدين، يوم رحيله!
أحاول في هذه الورقة أن أدافع عن كل إنسان نبيل كميشيل، لأبين مدى الخواء الإنساني عند بعض المتدينين، البعيد عن هدي القرآن الكريم، عندما يحاولون الإساءة إليهم، بذريعة فتاوى تاريخيانية تقول: “لا يجوز الترحّم على غير المسلم”!
في الأصل كلنا مسلمون
يتذرعون بأن الله لا يقبل عمل أي إنسان، ما لم يكن مسلمًا من مِلة محمد ﷺ، مستدلين بالآية الكريمة: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران:85. ونقول: لقد أكد القرآن أن أتباع الرسل كلهم مسلمون، من نوح إلى إبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى، في آيات واضحة الدلالة، منها: {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة:133. {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران:52. ولم تُذكر كلمة دين بصيغة الجمع في آي القرآن كلها، لأنه دين واحد، فلا يُعقل أن يكون الإله واحدًا، وله ثلاثة أديان، إنما هي مِلل، كما أكد القرآن: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} النساء: 125. وفي موضع آخر، لا لبس فيه، يؤكد القرآن أن مثلث النجاة يوم القيامة يقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، من أي مِلةٍ كانت، وما تبقى ليس إلا تفاصيل دونها، حيث يقول: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} المائدة:69. هذا من حيث أصل الإيمان، فكلنا مسلمون، وبذلك نفهم الآية {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ}.
إبطال القراءة العضينية في عدم الجواز الترحم على الآخرين
يستدلّ أصحاب الخواء الإنساني، في عدم جواز الترحم على الآخرين، بفتوى لابن تيمية والنووي وغيرهما من أئمة الدين الموازي، تستند إلى آية في سورة التوبة يجتزئونها من سياقها، تقول: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} 113.
لنضع هذه الآية في سياقها، وندرس سورة التوبة: سورة التوبة من أكثر السور التي ذُكر فيها (المشركون) وهذا المصطلح لا يُراد به أهل الكتاب من يهود ونصارى، لأن القرآن إذا ذكرهم، أطلق عليهم (أهل الكتاب أو اليهود أو النصارى)، وأما المشركون هنا، فهو يقصد جماعة محددة موصوفة من العرب، عاهدوا رسول الله زمن الرسالة، ونكثوا عهدهم معه، ونقضوا ميثاقهم، لذلك لم تبدأ السورة التوبة بالبسملة، إنما تبرأ الله منهم، ومع ذلك منحهم فرصة أربعة أشهر، ليراجعوا أنفسهم، وهذا يعني أن الآية زمكانية تتحدث عن واقعة تاريخية حدثت زمن الرسالة، وليست عامة إطلاقًا، ومطلع السورة يؤكد ذلك: {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ}.
وجميع الأحكام الواردة في سورة التوبة، كالبراءة من المشركين والنهي عن موالاتهم وإقامة العلاقات الاجتماعية معهم وعدم الاستغفار، مناطها ليس الشرك، إنما نقض العهد والنكث به والغدر، لذلك تقول السورة بعد البراءة منهم مؤكدة غدرهم: {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًا وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ}10. فالتبرّؤ منهم عِلَتُه الغدر والنكث والعدوان، وليس الشرك، بدليل أن السورة تقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} 6.
فكيف تقاتلهم كلهم ولا تستغفر لهم، ثم تطلب السورة منك إجارته؟! إذن سياق الآية يؤكد أنها تتحدث عن واقعة تاريخية، لا تأخذ في أحكامها صفة الديمومة، حتى نُسقطها على آخرين، وتنتفي فيهم صفات أولئك المشركين الذي نكثوا وغدروا واعتدوا، بانتفاء عدوانهم علينا.
الترحّم غير الاستغفار
لو قبلنا جدلًا بأن الآية لها صفة الديمومة، فالآية تتحدث عن الاستغفار لا عن التَرَحّم، والفرق بينهما كبير {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ}، وبالتالي يجوز الترحّم على من هو من غير ملتنا، لأن الترحم فيه صلة رحم مع الآخر، كي تذوب الحساسيات الدينية بين الملل، فالتّرحم من الرّحمة، وقد عرّفه الراغب الأصفهاني: “الرّحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وتستعمل تارّة في الرّقة المُجردة، وتارّة في الإحسان المُجرد عن الرّقة، نحو رحم الله فلانًا”. وحتى لو كان استغفارًا، فقد ثبت بنص القرآن، أن الله أمر ملائكته بالاستغفار لأهل الأرض كلهم: {وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ} الشورى:5. و(مَن) هنا لعموم الناس، إلا إذا جاءت قرينة تُخْرِج أحدهم من عموم هذا الاستغفار الملائكي. ونحن لا نستغفر لهؤلاء المشركين الذين ذكرتهم السورة، الموصوفين تاريخيًا، إنما نستغفر ونترحم على إنسان قدّم خيرًا لوطنه وللإنسانية، وما كان فاسدًا ولا مفسدًا. فكيف بمن هو إنسان ناضل ضد الاستبداد ونادى بالحرية لنا جميعًا، على مدار أكثر من نصف قرن، كالأستاذ ميشيل، ومثّل الثورة في المحارب الإعلامية والدولية خير تمثيل، بل وقف حتى ضد الكنيسة التي ناهضت ثورات الربيع العربي، كما في لقائه الشهير مع محطة (فرانس24).
محاجّة عقلية
القرآن الكريم أباح مصاهرة أهل الكتاب وزيارتهم وأكل طعامهم والمتاجرة معهم، فهل يُعقل أن يبيح الأعلى، ويمنع الأدنى كالترحم!؟ إذ قال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} المائدة:5. ولا ينهانا القرآن عن الإحسان والبرّ إلى من هم من غير مِلتنا، ما داموا ليس معتدين ولا مفسدين: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة:8. والبِر أرقى أنواع الوصل الآدمي، وأكثرها إحسانًا من حيث الإنسانية، ومنه جاء برّ الوالدين، ومن سلوكاته المعاملة بما هو أقوم إنسانيًا، وأما القسط فهو مرحلة سلوكية أعلى من العدل مع الآخر. إنْ في المعاملة أو المعاشرة، وهذا أقل ما يجب أن نقوم به تجاه أستاذنا ميشيل فارس الحرية الذي ناضل عقودًا ضد الاستبداد، فهل يُعقل أن نكافئه بعد موته، بفتاوى لا إنسانية تمنع الترحم على هذا السوري النبيل؟!
الحقوق المشتركة
يطرح القرآن مبدأ الحقوق المشتركة مع الآخرين، بحيث لا يكون جزاء الإحسان لهم إلا بالإحسان، ومن الحقوق المشتركة أن إخوتنا في الوطنية من المكونات الأخرى يهنئوننا في أعيادنا ومناسباتنا الدينية، ويشاركوننا في أفراحنا وأتراحنا، والقرآن يطالبنا برد الإحسان بالإحسان، ويستنكر على من ينكره بقوله {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}. ويطالبنا برد الحقوق المشتركة من تهنئة ومباركة وتعزية بقوله: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء:86. وإن أي رفض في رد التحية للآخر دليلٌ على عنصرية دينية، مرفوضة في دائرة الإيمان، ومسيئة للإسلام. ثم إن القرآن حض على ثقافة التشاركية، ونبذ ثقافة القطيعة، بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الحجرات:13. وقوله (لتعارفوا) هنا دعوة للتشاركية، أليست التهنئة والتعزية واللقاءات والحوارات والترحم على الموتى، تدخل في قيمة (لتعارفوا). وتكفير الآخر، ورفض الترحم عليه، والإساءة إلى الرموز الوطنية والثورية، هي مخالفة لمبدأ التعارف! وكيف إذا كان المتوفى رمزًا وطنيًا لم تشهد مواقع التواصل طوال العشرية السوداء إجماعًا سوريًا على شخصية ثورية، كالإجماع الذي ناله الفارس الوطني ميشيل، إذ حزن على وفاته السواد الأعظم من الشارع الثوري، فبأي ميزان تزنون إيمانكم المغشوش؟
القرآن يقدم الولاء السياسي على الولاء الديني!
يطرح القرآن قضية الولاء، بطريقة مدهشة، إذ يقدم الولاء السياسي على الولاء الديني، بين قومين بينهما حرب، وربما يستغرب كثير هذا الاستنباط، فتعالوا لنقرأ ذلك: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} الأنفال:72. إن هذه الآية تؤكد أن الولاء السياسي مقدم على الولاء الديني، وهذا ما يمارسه كلّ البشر، ففي الحرب لا يقيم المتحاربون وزنًا للعلاقة الدينية في قضية وطنية، فلا قيمة لإيمان إنسان شارك ضدك في معركة الحرية والاستبداد، ولذلك لم يكن ميشيل كيلو منحازًا للحرية والعدالة الاجتماعية فحسب، إنما كان أهم قادتها التاريخيين، وفارس الثورة إعلاميًا وسياسيًا، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. ولكون أتباع الدين الموازي لا يقبلون الدليل القرآني، ويفضلون الدليل التراثي، فإني أقدّم لهم دليلًا على تقديم الولاء السياسي على الديني من التراث، حيث ذكر الطبري في تفسيره ذلك: لما أسرَ المسلمون العباسَ وعقيلَ ونَوْفل في معركة بدر، قال رسول الله ﷺ للعباس: افدِ نفسك وابني أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصَلِّ قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: “يا عبّاس، إنكم خاصمتم فَخُصِمتم”! هنا الرسول لم يقبل من العباس إيمانه برسالته وشَهِد له وصلى معه وهو عمّه، إنما قدم الولاء السياسي على الديني، وطالبه أن يفدي نفسه كأسرى مشركي قريش. فهل قرأ أتباع الدين الموازي القرآن أو تراثهم؟ أم أنهم قوم لا يعقلون؟
إن الراحل ميشيل كيلو صفحة مشرقة في تاريخ سورية المعاصر، ولا يستطيع المشاغبون أن يسيئوا إليها، ولكنهم بالتأكيد يسيئون إلى أنفسهم وإلى تدينهم، وهو فارس الحرية على مدار أكثر من نصف قرن، وقد أثبت وطنيته وإنسانيته، ولم ينسَ أبناء وطنه، وهو على فراش الموت، حيث كان يقدّم خلاصة تجربته، ونصائحه، دون كلل ولا ملل، وكان يحلم بسورية حرة مستقلة لكل أبنائها، حتى غلبه ذلك الفيروس اللعين، وجعله يترجل إلى دار الخلود عن فرسه. ألف رحمة ونور على روح أستاذنا ميشيل كيلو السوري النبيل.
وختامًا أقول: مَنْ فقد إنسانيته؛ بَطَلَ تَدَينُه.
———————-
ميشيل كيلو الإنسان والمفكر والسياسي/ محمود الحمزة
عبّر السوريون، بمختلف مشاربهم، عن الألم والوجع الذي تركه رحيل المفكر والسياسي المخضرم ميشيل كيلو، وشهدنا حالة إجماع شعبي ووطني لافت في وداعه، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات والندوات التي أجمعت على أن الراحل ميشيل كيلو كان شخصية استثنائية بكل المقاييس.
فقد كان إنسانًا بسيطًا وشعبيًا، وروحُه طيبة في الحديث، وكان يستخدم عبارات من قلب المجتمع السوري، ليؤكد ارتباطه العميق بوسط اجتماعي ترعرع فيه وانتمى إليه بتربية سورية حقيقية، ويمكن وصفه بأنه كان سوريًا، في أعماق قلبه وفي سلوكه وفي تعامله مع الآخرين. كان يهتم بالأصدقاء والشباب والمثقفين والثوار، وبكل من يعمل لحرية سورية وكرامتها، وكان إنسانًا بحروف من ذهب، لأنه لم يضَع نصب عينيه إلا مصالح السوريين وطموحاتهم، وكان لديه نظرة واسعة وقلب كبير يتعامل من خلاله مع الناس، فيرى الجانب الإيجابي حتى في الشخص الذي سُجن من أجل التهريب والتقى معه بالسجن، لأنه كان يثق بالناس، ودائمًا يبحث عن أسباب الظواهر، ويدعو لمعرفة أسباب القيام بأي فعل. فعندما يقوم الفقير بأشياء منافية للقانون، يجب معاقبة من أوصله إلى هذه الحالة، ذلك الذي حرمه من لقمة العيش وجرده من حقوقه الإنسانية.
كان إنسانًا رقيقًا. ويظهر ذلك من قصته في السجن مع الطفل الذي طُلب منه أن يحكي له قصة، ولكن الطفل الذي وُلد في السجن لم يكن قد رَأى الشمس ولا الشجر ولا العصفور، فأبكاه حال ذلك الطفل. ونكتشف من حكاياته وممارساته أنه يهتمّ بشؤون الناس، ويتألم لمعاناتهم، وكان يحلم بالعودة إلى سورية وإلى ريف اللاذقية، ليجلس على تلة صغيرة يتذكرها منذ الطفولة. إنه مرتبط بسورية وتراثها وأهلها، وبالعادات السورية في الطيب والكرم والعيش بنظافة وبشهامة الإنسان السوري البسيط.
ميشيل كيلو مثقفٌ من الطراز الرفيع، وهو موسوعة الذاكرة السياسية والتاريخية السورية. عرف تاريخ سورية الحديث، وعاصر أهمّ الأحداث، وكان مساهمًا فعالًا في نشاطات الحركة السياسية والثقافية السورية، واكتسبت شخصيته شهرة واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية، وعُرف عنه جرأته وشجاعته في قول الحقيقة، وكان سياسيًا مخضرمًا يُتقن الحوار ومجابهة أشرس الخصوم حتى ضباط الأمن الكبار. وكان يحظى باحترام السوريين -معارضين وموالين- وهو من أبرز الشخصيات المعارضة التي ساهمت في تطوير الفكر السياسي والثقافي، وقد مارس العمل السياسي عمليًا، ودخل السجون مرات عدة، ودائمًا كان في قلب الحدث بالكتابة والحديث والنشاط الفعلي.
كان ميشيل كيلو إنسانًا حكيمًا، ولديه طاقة هائلة في التفكير والتحليل الذي يستند إلى خبرة غنية وثقافة واسعة بالمجتمع السوري، وقد كان يقول: يجب على من يتصدّر المشهد السوري أن يكون عارفًا بسورية والمجتمع وتفاصيل الحياة، معرفة قريبة وعميقة وواقعية، لا معرفة نظرية فحسب، وكان هو يجسد هذه الظاهرة.
ترجم كتبًا سياسية وفكرية وتاريخية مهمّة، أغنت المكتبة العربية، وألّف عددًا من الكتب والروايات والقصص الأدبية. وكان أبو أيهم -رحمه الله- مدرسة في السياسة، وكلّ من يعرفه وتواصل معه يشعر بأن أمامه إنسانًا هو عبارة عن مكتبة متنقلة، وتراه يتحدث عن القضايا الكبرى، ويلخصها بكلمات، ويضرب أمثلة قد تكون حكايات بسيطة تثبت فكرته.
لقد شهدت كلّ الأحداث الكبيرة المتعلقة بالحياة السياسية المعارضة للنظام أن ميشيل كيلو كان في المقدمة، وكان سباقًا في تقديم المبادرات لإنشاء لجان إحياء المجتمع المدني وإعلان دمشق، ولا يوجد معارض سياسي في سورية إلا واحتك به وتعلّم منه. ويشهد له السوريون كيف وقف في اجتماع مع مسؤولين في النظام (وتم تسجيل ذلك اللقاء) وقال كلامًا وطنيًا جريئًا غير مسبوق، حتى إن كاتبًا من حلب روى أنه كان يحمل شريط التسجيل في الشارع، وهو خائف من الاعتقال، كما أكدت المقترحات التي قدّمها مع شخصيات وطنية أخرى، بدعوة من مسؤولين في البعث، للجنة الحريات والديمقراطية خلال التحضير للمؤتمر القطري الذي عقد عام 2005، أن أفكاره القوية والمقنعة لاقت رواجًا كبيرًا في الشارع السوري، وأجبرت النظام على تقديرها ومحاولة الاستفادة منها، لكي يحمي نفسه من احتمال تغيرات ثورية قادمة، ولكن نظام الأسد (وخاصة في عهد بشار الذي يسميه كيلو تهكمًا بـ “العبقري”)، كما يشير ميشيل كيلو، اتخذ طريقًا معاديًا للشعب، ودمّر الاقتصاد والسياسة والفكر والحياة. ووضع سورية في سجن كبير سائر نحو الانفجار المتمثل الثورة السورية العظيمة في آذار 2011.
تعرّفت إلى ميشيل كيلو، شخصيًا، في السنوات الأولى للثورة، وكان أول لقاء معه في إسطنبول، وكان متواضعًا ودودًا، وسهرنا ساعات وحدنا، ويومها طرحت عليه أسئلة صريحة، وانتقدته بأدب وتواضع على نشاطه في الائتلاف؛ فشرح لي بالتفصيل ما حدث، وقال (بالمعنى): “لقد اخطأنا باختيارنا لأحمد الجربا، لأنه أخلف الوعود التي قدّمها لنا”. ولذلك كتب ضده، وخرج لاحقًا من الائتلاف، لقناعته بعدم جدوى الائتلاف بعد أن ارتهن لجهات خارجية.
آمن ميشيل كيلو بوحدة الشعب السوري، ورفض الطائفية والمللية، وشرح في مقابلاته وفي كتبه سبب الطائفية في سورية، وكيف أن رجال الدين هم تابعون للحاكم المستبد الفاسد، وأن السوريين يجب أن يعملوا على بناء دولة مواطنة، تلغي التمييز بينهم على أساس الدين أو الطائفة أو الجنس.
لقد ترك إرثًا غنيًا من الأفكار الثقافية والسياسية والاجتماعية التي يجب أن يرجع إليها الشباب ويدرسوها، وعليهم أن يتابعوا مقابلاته بالفيديو، ويستفيدوا من المنطق السياسي وطريقة التفكير العميقة والشاملة للظواهر وربط الأحداث ببعضها.
من أهمّ ما ترك ميشيل كيلو كتابه الأخير، الذي عمل عليه بشكل مكثف وكأنه كان يسابق الزمن لإنجازه، وعنوانه “الانتقال من الأمة إلى الطائفة….”، وهو موسوعة التاريخ السوري وحكم العسكر وحزب البعث الذي تأسس عام 1946، واستلم السلطة بانقلاب عسكري عام 1963، وحوّل سورية من مجتمع متجّه للتبلور كمجتمع وطني سوري، ومن أمّة (كما وعد البعثيون في شعاراتهم)، إلى طائفة، حيث فرق بين الأفراد وبين الجماعات والأسر، لكي يسيطر عليهم.
لقد أثبت في كتابه الكبير (وكان لي شرف الاطلاع عليه كمخطوطة ومراجعته بطلب من الراحل) أن البعث والتوجه الطائفي في النظام دمّر سورية مجتمعيًا، وحرم الناس من كل حقوقهم، وأصبحت عائلة الأسد هي مالكة البلاد والعباد.
بعد دخوله المشفى، رحمه الله، كنا نتراسل، وكان يسألني عن صحتي، ويطلب مني وضعه في صورة التطورات الصحية الخاصة بي.
لقد رحل ميشيل كيلو، وبقي إرثه الثقافي الغني الذي يجب جمعه ونشره وتوزيعه، لأنه مكتبة للثوار والسياسيين والمثقفين السوريين والعرب.
لقد كان رحيلك، يا أبا أيهم، خسارة لسورية، وخسارة لكل واحد منا.
————————-
أسئلة غائبة على هامش رحيل ميشيل كيلو/ عبدالله أمين الحلاق
يثير رحيل الكاتب والمثقف والمعارض السوري ميشيل كيلو مشاعرَ حزنٍ وأسى كبيرة، كما يحفّز، في الآن عينه، على طرح أسئلة كانت وما تزال غائبة، ولا يبدو أن مجال طرحها بسهولة والنقاش حولها سيكون متاحاً في السنوات الكثيرة القادمة، سواء رُحِّل بشار الأسد عن السلطة أم لم يُرحّل.
كيلو، المناضل الذي قضى أكثر من نصف عمره في مقارعة نظام التوحش في دمشق، والمثقف الثمانيني الذي لم يكتم في معظم مقابلاته التلفزيونية شوقه للعودة القريبة إلى “سوريا الحرة” التي حلم بها وعمل لأجلها، قضى مؤخراً في بلد المنفى، فرنسا، في زمنٍ تبدو فيه “الحرية” التي نشدها طويلاً ممنوعة وممتنعة على السوريين و”بلدهم”.
في هذا ما يبعث على الألم تجاه جيل سوري ينتمي إليه الرجل، جيلٌ بات اليوم في السبعينات والثمانينات، وأحياناً التسعينات من عمره، وباتت أسماء أبنائه علامات مقترنة بمقارعة نظام الأسدَين، الأب والابن، من دون أن يقطفوا ثمار القضية التي نذروا أعمارهم وحيواتهم لأجلها.
في المقابل، ثمة مسائل ونقاشات تبدو ملحّة اليوم، بالتزامن مع موجات الحزن الكبير التي تخللتها، أحياناً، رسائل لترهيب والتشكيك بوطنية ومعارَضة كل مَن يمكن أن يتفوه بعبارة نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحافة تجاه “أبي أيهم” بعد وفاته.
وغنيّ عن القول إن مقولات من قبيل “حصانة الميت” و”حرمة الموت” هي من تلك “الكليشيهات” التي تنهل من منهل ديني، لا سياسي، في بلد يسبح كثرٌ من “مثقفيه” في بحار التقديس والتطويب والأيْقَنة وعبادة الفرد، هذا بالإضافة إلى أن المشتغل في الشأن العام يُفترض أن يبقى، على ما نفترض، عرضة للنقد في ما كتبه وقاله ونقَله إلى ما بعد رحيله. يصح ذلك في كارل ماركس كما يصح في أبي هريرة، رضي الله عنهما طبعاً.
وصل الفرز الفيسبوكي السوري على خلفية رحيل كيلو، في بعض محطاته ولَطمياته، إلى ضرورة التمييز بين أشخاص “محترَمين” وآخرين “غير محترمين”، بحيث يكون معيار الاحترام هو الموقف من ميشيل كيلو، وأصبح كل مَن ينتقد الفقيد في أحايين أخرى، من وجهة نظر البعض، “أقرب إلى النظام” منه إلى المعارضة، وهلم جراً من أجواء تغرف مما أنتجه “الربيع العربي” في سوريا من شعارات أبرزها “كسر حاجز الخوف”، عبر موجات التخويف والتخوين المستحدثة.
لا يهدف هذا النص إلى إعمال مبضع النقد في كتابات ونصوص كيلو، لا عبر النقد ولا عبر النقد المضاد، كما أن أداءه السياسي والذي وصفه بعض المتيمين به بـ”الإبداع السياسي والبراغماتية الفذة” يحتاج ورقة بحثية مطولة وخاصة في “البراغماتية” كمفهوم.
أضف أنه من الظلم تناول الرجل بالنقد، كشخص، وإغفال كونه جزءاً من إطار أوسع يحفل بالتناقضات وفي القفز غير المفهوم بين المراكب والأمكنة واستحضار الشعارات الرنانة وتحويلها إلى شرائع، أي باعتباره نموذجاً لحالة سورية يبقى كثيرون من رموزها، مثقفين أو سياسيين أو ممَّن يحوزون اللقبين معاً، على كل ما قاموا به من سلوك وأداء مأساوي، أشخاصاً لا يمكن تحميلهم بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن نتائج ومآلات كارثية كالتي آلت إليها سوريا، وإنْ يكن ثمة مسؤولية أخلاقية تتعلق بصون كرامة المعارضة وشرفها، أقلّه من خلال الاتساق المطلوب بين “الفكر” والممارسة.
ننحاز إلى ضرورة الفصل والتمييز بين ميشيل المناضل وبين ميشيل الكاتب والمثقف الذي وصل الأمر بالبعض بعد رحيله إلى وصفه بـ”وريث إلياس مرقص وجورج طرابيشي”. فالإنسان -الكاتب أو المثقف أو غيرهما- يخطئ ويصيب في التحليل والتفسير والتأويل طبعاً، وهي سمة تلازم المناضل السياسي أيضاً وبالضرورة، مع ملاحظة فارق يبدو لنا أساسياً، وهو أن الراحل كان قادراً على دمج الاثنين معاً، الكاتب والمناضل، وهي حالة ليست الأولى من نوعها في التاريخ وكثيراً ما ثابر عليها كل مَن يمكن وصفه بـ”المثقف العضوي”، لكنها قد تكون كذلك من خلال امّحاء أي فارق أو حد يفصل بين هذين، لدى كيلو ولدى آخرين غيره، بحيث يصبح التمييز بينهما في النص مستحيلاً، كما يتعذّر، والحال على ما هو عليه، التفريق بين المقال وبين البيان السياسي-الحزبي الذي تتسرب الشعارات من شقوقه الكثيرة أكثر مما تتسرب الأفكار.
واستطراداً، وباستعارة جزء من تعريف غرامشي للمثقف العضوي باعتباره “منتمياً إلى طبقة يتصدى دائماً للدفاع عنها وعن مصالحها”، وعلى رغم أن سوريا بلد لم تتشكل فيه الطبقات بالمعنى الحديث للكلمة، أسوةً ببلدان مشرقية (وشرقية كثيرة)، إلا أنه بلد شهد انقسامات وتمايزات ومفاضلات اجتماعية وطائفية وإثنية، وعصبيات واحترابات تحوّل كل منها إلى قضية بحد ذاته.
وإذا صح أن ميشيل كيلو كان “مثقفاً عضوياً” بالمعنى الغرامشي على ما يعتبر كثيرون، بات من الممكن القول إن تحوّلات مفهوم المثقف العضوي وتبدلاته مع تبدلات العالم ودور المثقف وأدواته، وطبيعة القضايا المحلية والعالمية اليوم، هي تحوّلات تبقى منفية ومطرودة إلى خارج السياق السوري في الحالة هذه، ما يجعل من سوريا بلداً خارج الزمن وخارج العالم وفوق التاريخ، بلداً ذا بعدٍ واحدٍ وقضية واحدة هي “الوطنية السورية” المفترَضة والمتخيَّلة، ويجعل كل انتباه إلى قضايا قديمة كانت مكبوتة وانفجرت في وجه الجميع، انتباهاً مرذولاً أو مردوداً إلى سوية واحدة هي “النظام فقط”. فـ”كل أشكال التفرقة القومية والدينية والطائفية والمناطقية التي تُغرق السوريين راهناً، كان يراها كيلو وليدة ظرفٍ سياسي خاص فحسب، ناتج عن الاستبداد المديد. حيث سيعني وسيؤدي إسقاطه حسب الراحل إلى نهاية كل أشكال التفرقة والصراعات البينية تلك، وتالياً العودة إلى الأصول ‘البريئة’ التي كانت”، على ما أشار رستم محمود في مقال له.
كان ميشيل كيلو، فعلياً، مثقفاً عضوياً بالمعنى الحرفي للكلمة، وبالمعنى الذي ولد فيه المفهوم في “دفاتر السجن” لأنطونيو غرامشي قبل أقل من مئة عام بقليل، أي أنه المثقف الذي ينتمي إلى “طبقة سياسية” هي “المعارضة السياسية الرسمية”، علماً أنها “طبقة” من سوية عصَبية في جزء كبير منها، يدافع عن مصالحها باعتبارها صنو “الثورة” من منظوره ومن منظور حُكمه على هذه المعارَضة أو تلك، تبعاً لوجوده في أيّ منهما. وكان أيضاً يهدف إلى “التغيير الديمقراطي” الذي يعادل، بالقياس إلى ثلاثينيات القرن الماضي، “وصول الحزب المعبر عن مصالح الجماهير إلى السلطة”.
هنا تغيب التمايزات لصالح “الوهم المقدّس” ممثلاً بافتراض أن القضية السورية قضية واحدة، وأن السوريين شعب واحد، ولا يهمّ تأجيل كل نقاش في ما هو تحت هذا السطح أو نفيه بحجة “القضية المركزية”.
يمكن الاستفاضة كثيراً في هذا الموضوع، في إطار النقد السياسي والتعاطي الثقافي مع كيلو كظاهرة سورية من ضمن ظواهر كثيرة مشابهة أو مختلفة. يحتاج الخوض في الأعوام العشرة الأخيرة وما حصل فيها إلى مساحات وأوراق كثيرة، وإلى ورشات وحوارات جماعية مطولة وإلى ما يمكن تسميته بـ”عمل الذاكرة” المترافق مع مراجعات جارحة ومن العيار الثقيل جداً، ربما “وفاءً” لمناضل كبير في مواجهة الاستبداد مثل ميشيل كيلو كان يشدد دائماً في كتاباته على ضرورة المراجعة النقدية، وإن كان يعفي نفسه عن ضرورة الخوض فيها بشكل جدي.
بعيداً عن ذلك، يبقى مؤكداً أن النضال السوري المديد في مواجهة الاستبداد خسر واحداً من أبرز رموزه طوال خمسين عاماً من تاريخ هذا البلد ومن عمره القصير.
رصيف 22
———————-
====================
تحديث 25 نيسان 2021
——————–
المعارض النجم/ راتب شعبو
قليلون في سورية مَن لم يسمعوا باسم ميشيل كيلو، فقد طاف اسمه على حقبة طويلة من تاريخ سورية المعاصر، ليس من موقع سلطوي، بل من موقعه كمثقف مستقل خارج السلطة وكمعارض لها. كثيرون غيره دخلوا معترك الشأن العام السوري، كثيرون غيره كتبوا وواكبوا واعتُقلوا، وكانوا أكثر شجاعة منه في معارضتهم للنظام، لكن اسم ميشيل كيلو بقي الأكثر لمعانًا. لا يوجد في تاريخ المعارضة السورية من حقق الشهرة التي تمتع بها ميشيل كيلو.
هل لأنه لم يلتزم بحزب محدد، فلم يُحتجز اسمه في خانة حزبية محددة؟ هل بسبب نشاطه وحضوره الدائم في مختلف أنشطة المعارضة؟ هل لأنه لم يكن دوغمائيًا في نظرته إلى الواقع السياسي، أي لم يكن ضعيفًا أمام سطوة فكرة مسيطرة تجعل معتنقيها يعتقدون أنهم مُخلِّصون، ويتحولون في إيمانهم هذا إلى عبيد “مُخلصين” للفكرة؟ لقد استطاع الرجل، مع آخرين، أن يرى قصور التصور الاشتراكي، وأن يرى الديمقراطية هي الخيار الذي يمكن أن يخرج بالمجتمع السوري من جورة الاستبداد والعطالة. ربما كان ذلك بتأثير من إلياس مرقص “معلمه وصديقه”، هكذا يصفه في إهداء روايته أو “قصته الطويلة”، كما يعرفها (دير الجسور).
ولكن التحول الديمقراطي المبكر (أي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي) لميشيل كيلو، وضعه أمام أسئلة عويصة، مثل العلاقة مع الجماعات الإسلامية، والعلاقة مع النظام (ليس بوصفه سلطة قمع، بل بوصفه كتلة مصالح لا يمكن لديمقراطي ألّا يعترف بها)، وأيضًا العلاقة مع الشارع من موقع ديمقراطي، أي غير وصائي.
لقد ظهر أن التحرر من سطوة الفكرة الاشتراكية يلقي على كاهل المرء أعباء أثقل، وكأن هذا التحرر ليس إلا طريقًا إلى معترك نضالي فعلي شديد التعقيد. الفكرة الاشتراكية كانت تريح معتنقيها من هذه الأعباء، فهي في صيغتها البسيطة أو المبسطة تقول (لا) كبيرة، للإسلاميين وللنظام، وتقول (نعم) كبيرة للشارع أو الشعب أو الجمهور، بوصفه مكمنًا لثورة اشتراكية، أو سبيلًا إلى السلطة التي تكون وسيلة تمارس “الطليعة الاشتراكية” عبرها وصاية على شعب جاهل، شعب قادر على الثورة، ولكنه جاهل بمصالحه.
صحيح أن هذا المسار الذي سمي اشتراكيًا، يلقي على عاتق رواده أعباء نضالية كبيرة وخطيرة، لأنه يضعهم في مواجهة حادة مع قوى ثقيلة، وأنه مسار يختار رواده من الشجعان ومن ذوي الكفاحية العالية، لكن المسار الديمقراطي لا يقلّ صعوبة، وإن كان يتطلب خصالًا أخرى من رواده، مثل القدرة على الاعتراف بالآخرين وفهم مصالحهم وأخذها في الحسبان، والتخلي عن مبدأ السيطرة، وعن فكرة الطليعة، وتخفيف العدائية تجاه المختلفين… إلخ، وهذه خصال أقلّ توفرًا ولكنها أكثر جدوى.
كان ميشيل كيلو من رواد المسار الديمقراطي، وقد تكبّد خسائر على هذا الطريق. لم يكن كيلو حازمًا في نظرته الى نظام الأسد، يمكن القول إنه كان ذا ميل إصلاحي، وكان لا يمتنع عن العلاقة برجالات من السلطة أو من محيطها غير الرسمي. على هذا المستوى، لم يكن تطهريًا. كان يعتقد أن السلطة ليست صخرة صماء بلا خطوط تباين، يمكن ملاحظتها والاستفادة منها والولوج إلى معطيات مفيدة، وحتى ممارسة التأثير فيها. لم يكن وحيدًا في هذا التصور، ولا سيما بين المثقفين، ولا يمكن إنكار هذا التصور على أحد. غير أن خطورة هذه المعارضة اللاعدائية، إذا جاز القول، تكمن في الجذر العدواني للسلطة الأسدية التي ترتد بعنف على غير المتسقلين، فما بالك بالمستقلين أو الناقدين أو أصحاب الطروحات الديمقراطية. خسر ميشيل كيلو في “إصلاحيته” هذه، أي في افتراضه وجود إمكانية للعمل ضمن حدود النظام، ثقة شريحة من المعارضين الجذريين الذين لم تكن معارضتهم أكثر جدوى، على أي حال.
شيء مشابه يمكن ملاحظته في علاقة ميشيل كيلو مع الإسلاميين ونظرتهم إليهم. من السهل الخلاص من موضوع الإسلاميين برفضهم جملة وتفصيلًا، وقد يكسب أصحاب هذا الموقف صفة الوضوح والجذرية والثورية الحقة. غير أن هذا الموقف، بطبيعة الحال، لا يحل المشكلة، وهو نفسه موقف الاستبداد، ولكن من موقع معاكس. القاسم المشترك بين الموقفين هو إلغاء المشكلة، بإنكار حق أصحابها بالوجود هنا، أو بمحو أصحابها بالقمع المادي هناك.
لم يذهب ميشيل كيلو في ذاك الطريق السهل بالتعالي على المشكلة أو القفز عنها، بل قاده تصوره الديمقراطي إلى الانفتاح على الإسلاميين، وكان في هذا جزءًا من تيار يساري سوري حاز زخمًا غير قليل بعد اندلاع الثورة السورية. ولكن قبل اندلاع الثورة، كما بعدها، وجد ميشيل أنه يراكم الخيبة من الإسلاميين، كما راكمها من النظام، وأن الإسلاميين لا يختلفون عن النظام، في استتباع كل من هو أضعف منهم، ويأتي ساعيًا إلى علاقة “تحالفية” معهم.
مع الشارع، كان ميشيل كيلو مميزًا في انفتاحه على الجميع، حتى المختلفين، كان يمارس ما أوصى به السوريين. ففي وصيته التي كتبها قبل وفاته بأيام، كتب: “التقوا بمن هو مختلف معكم”. والحق أنه كان موهوبًا بقدرة هائلة على التواصل مع كل المستويات الاجتماعية، ومع كل الأعمار. تجده نشطًا في الندوات، وعلى صفحات (واتساب) التي تنشغل بالشأن السوري العام. لم يكن يميل إلى اللغة الصعبة، في حديثه أو في كتاباته، دون أن يكون سطحيًا بأي حال. وكان يستطيع الاحتفاظ بحرارة العلاقة مع مئات الأشخاص، حتى يبدو لكل منهم إنه مميز لديه.
وثق به أشخاص بسطاء إلى حد أنهم كانوا يستشيرونه في إمكانية عودتهم إلى بيوتهم في إدلب، معتقدين أنه يدرك مسار التطور العسكري والسياسي في المنطقة. بالمقابل، خسر ثقة قطاع غير قليل من الناس، ولا سيما المثقفين والمتابعين منهم، وقد اشتكى غير مرة من حملات اتهام طالت نزاهته. المثقف (الكاتب في الشأن السياسي) ينبغي ألّا يناور، وتكمن قيمته في نزاهته، فيما يناور السياسي في الغالب، والجمع بين الأمرين لا بد أن يعود على صاحبه بالاتهامات.
بعد كل شيء، يبقى ميشيل كيلو أحد ألمع نجوم المعارضة السورية، على مدى يزيد عن نصف قرن، ولم ينته حتى 19 نيسان 2021.
مركز حرمون
—————————
ميشيل كيلو والطائفية/ بشير البكر
تربى ميشيل كيلو في بيت شيوعي ستاليني، وعاش حياته السياسية والفكرية وسط عالم العلمانيين والعروبيين وحتى الإسلاميين المتنورين والمعتدلين، ونظر إلى الطائفية من زاوية السياسي العقلاني والمعارض الوطني التقدمي، ودخل في جدل حول الخطر المزعوم الذي ينتظر مسيحيي الشرق في حال سقوط النظام السوري، الذي قدمه البعض حامياً للأقليات، ورد على تهافت الأطروحة؛ بل عاب على بعض المسيحيين في سوريا وخارجها، أن يميزوا أنفسهم على نحو يضعهم على مسافة من بقية أشقائهم في بقية الطوائف الأخرى. وما يسند رأي كيلو هو أن المسيحيين لم يعانوا تمييزاً سلبياً خاصاً عبر تاريخ سوريا الحديث، رغم حصول هزات وانقلابات ومواجهات أهلية، وما نال بقية السوريين وقع عليهم.
ورأى كيلو أن المسيحية الشرقية ترتكب خطأً قاتلاً في انفكاكها عن “الجماعة التاريخية” على حد تعبيره. وشرح هذه الأطروحة في أكثر من مقال، ما أثار عليه حملات من النقد من طرف بعض الأقلام التي تقف في المعسكر الآخر. ولكنه ظل ثابتا عند الدعوة إلى “رد المسيحية إلى مكانها الصحيح من مجتمعاتها”. وذهب أبعد حين رأى أن واجب المسيحيين أن يبادروا إلى فتح هذا النقاش، أو عقد مؤتمر يضم ممثلين عنهم يلتقون في بيـروت أو القاهرة، “يتدارسون خلاله كل ما هو ضروري لرد المسيحية إلى موقعها التاريخي كجزء من المجتمع العربي/ الإسلامي”، وعليها بذلك أن تخوض معاركه وتشاركه مصيره، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وترفض اعتبار نفسه جزءاً من سلطاته أو خادماً لديها، فتتقاسم مع مواطنيها أقدارهم، سهلة كانت أو صعبة. بغير ذلك، لن تبقى المسيحية في هذه المنطقة، و”سيكون مصيرهم كمصير النظم التي يخدمونها: على كف عفريت، وخاصة إن انتصرت بالفعل جماعات الإسلام السياسي المتطرفة”. وفي بداية الثورة السورية رد كيلو على تصريحات بطريرك الموارنة بشارة الراعي التي أطلقها من باريس، حيث رأى أنه وضع المسألة في “سياق خاطئ”، واصفاً موقفه بـ “غير المنطقي” و”غير المقبول”. وشدد كيلو على أن البطريريك الراعي رئيس أقلية مسيحية في المشرق، وبالتالي هو لا يتحدث باسم المسيحيين. وقال: “الراعي يتحدث فقط باسم كنيسته، وهو لا يلزم أحداً بمواقفه”، لافتاً إلى أن أكثرية المسيحيين في سوريا هم من الأرثوذكس، أما الموارنة في سوريا فأقلية تنتشر في حلب وفي مشتى الحلو وحمص، وعدد محدود في اللاذقية، مؤكداً أن المسيحيين جزء أساسي من المجتمع السوري، وبالتالي يجب أن يكونوا راغبين في حل مشكلات هذا المجتمع المزمنة.
وتفرد كيلو في الموقف من الإسلام السياسي، والإخوان المسلمين تحديداً، وهو ردد في أكثر من مرة أنه “إذا كان رأيي تعبيراً عن ديموقراطية مدنية وعلمانية، ورأيهم تعبيراً عن ديموقراطية إسلامية، فلا ضير في ذلك ما دامت الديموقراطية هي القاسم المشترك بيننا، فسوف نقبل المسلمين الذين يتسلمون زمام السلطة عن طريق الانتخابات، شرط أن يقبلوا بالنظام الديموقراطي”. وخاض حوارات على هذا الأساس، وكتب مقالات من أجل كسر الحواجز، وإشراك جميع الأطراف في صياغة رؤية واحدة لسوريا المستقبل، وكان موقفه لافتاً من مسألتي السلاح والمذهبية في بداية الثورة، واتخذ موقفاً حاداً منهما. وبالنسبة إلى السلاح، فإنه “سيؤدي إلى معركة ينتصر فيها من يملك سلاحاً أكثر، ولديه الاستعداد لممارسة عنف أشد”، ذلك أن استخدام السلاح، يحول المعركة من صراع في سبيل حقوق إلى “همجية لا هدف لها غير قتل الآخر”. أما المذهبية فـ “ستحدث في حال نجاحهاـ نقلة نوعية في طابع الحراك الجماهيري وأهدافه وقواه، وستلعب دوراً كبيراً في رده إلى الوراء”. ورد ذلك إلى حال الوضع بين عامي 1978 ـــــ 1982، عندما همشت الحركة المسلحة الشعب، وخاضت معركتها على أسس مذهبية/ طائفية، كان من الحتمي أن تؤسس لموازين قوى أفضت إلى هزيمتها. وبالنسبة إلى كيلو ليست معركة سوريا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصير دينية أو مذهبية أو طائفية. سوريا تريد الحرية، ومن يحرفها عن هذا الهدف الجامع يخنها ويفرط بتضحياتها وفرصها، مهما كانت مسوغاته.
تلفزيون سوريا
—————————
وداعًا المعلّم المبجل/ أحمد طعمة
ما أصعب أن يفقد المرء صديقَه في لحظة تاريخية حرجة، فما با لكم عندما يفقد أستاذه وشيخه؟! نعم، كان أبو أيهم أستاذنا وشيخنا في السياسة، وكنّا مريدين عنده، نغرف من علمه وتجربته، فيا لحجم خسارتنا!
عرفت المرحوم الأستاذ ميشيل، بعد فترة وجيزة من صدور بيان الـ ٩٩ في أيلول عام ٢٠٠٠، الذي لم يكن لنا شرف التوقيع عليه، بل سبقنا إليه إخوة آخرون في الكفاح. عرفته مع مجموعة من الشباب الإسلامي المتنور الذي بدأ يتلمس طريق العودة للعمل السياسي، من بعد أن أُقصوا عنه طويلًا، متأثرين بالتجربة الناجحة للحكومة الائتلافية في تركيا عام ١٩٩٦، بين الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان وبين رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر، في حكومة أثبتت إمكانية التعايش بين الإسلام والعلمانية، على الرغم من قضاء العسكر عليها بعد عام، ما أكد أن مصابنا واحد، ومتأثرين أيضًا بكتابات إسلامية معاصرة، عبّدت الطريق لنا لقبول فكرة الديمقراطية، ومن أهمّها كتاب الشيخ راشد الغنوشي (الحريات العامة في الدولة الإسلامية)، فكان تعرّفنا إلى الأستاذ ميشيل تكريسًا لكل ما سبق، وكم أفادنا من فكرته الجوهرية التي قضى عمره منافحًا عنها، ألا وهي فكرة الحرية، إذ أضاءها لنا أحسن إضاءة، وبيّن لنا أن مشكلتنا الأساسية في بلادنا ليست الاختلافات الأيديولوجية، بل حكم العسكر واستبدادهم، وحرماننا جميعًا من الحرية.
كان أول من روّج في سورية -بحسب ما أعلم- لفكرة الدولة المدنيّة، فكانت لنا مخرجًا نحن معاشر الإسلاميين من حساسيتنا وقتها وحرجنا من فكرة العلمانية. كانت فكرة الدولة المدنية هي الحل الوسط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية وبين مفهوم الدولة العلمانية؛ فأقبلنا على تبنّي هذا المصطلح، وكان قاسمًا مشتركًا نشترك فيه مع إخوتنا في طريق الكفاح ضد الاستبداد.
وقّعنا بعدها على بيان الألف، كفاتحة خير لعمل مشترك يشمل جميع مكونات الشعب السوري، في توقه لنيل الحرية التي فقدناها طويلًا. ثم أصبحنا بعدها جزءًا من مشروع الأستاذ ميشيل، لجان إحياء المجتمع المدني، والذي قاده معه أساتذة كبار أمثال الأستاذ علي العبد الله والأستاذ فايز سارة والدكتور أكرم البني وآخرون، فكان خطوة إضافية قام بها الشباب الإسلامي المتنور متتلمذين على يد شيخنا بأن الديمقراطية تستحق التضحية من أجلها، مهما كان الثمن، حتى وصلنا إلى قناعة مفادها أن الديمقراطية قد تكون بالنسبة إلينا أقصر طريق يوصلنا إلى الجنة.
زارنا بعدها الأستاذ ميشيل في دير الزور، عام 2001 وما بعدها، واطّلع على تجربتنا الإسلامية المرتكزة على مجموعة أسس: لا إكراه في الدين (وهذا مرتكز الديمقراطية)، ولا للعنف ولا للتنظيمات السرية، وإن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (أي حتى يغيروا ما بعقولهم). فكان أن شجعنا ونصحنا بنصائح مهمة، بقيت عندنا نبراسًا لزمن طويل.
لستُ أنسى النسخة الأصلية من إعلان دمشق، وكانت من سبعة عشر سطرًا كُتبت في المغرب، وكتبها كل من المرحوم الأستاذ ميشيل كيلو والمرحوم الأستاذ حسين العودات والأستاذ علي صدر الدين البيانوني والأستاذ زهير سالم، في الأشهر الأولى من عام 2005، وأسست لإعلان دمشق، كجسم سياسي معارض، بموقف حاسم في مواجهة نظام الإجرام، ومطالب بحق الشعب السوري في نيل حريته وكرامته في ظل دولة مدنية ديمقراطية لجميع أبنائها. ويومها كان الإسلاميون في داخل سورية مترددين في الانخراط في إعلان دمشق، لأسباب عدة منها استمرار تأثير الضربة التي تعرض لها التيار الإسلامي في الثمانينيات، واعتقادهم أن مكونات الإعلان تشمل من ليس يتفق معهم في توجهاتهم، فضلًا عن قناعة التيار وقتها بأنهم القوة الضاربة في المجتمع، وليسوا بحاجة إلى الانخراط في كيانات مع غيرهم، فكان للأستاذ أبو أيهم ورياض الترك، وكبار الشخصيات السياسية المعارضة الأخرى داخل سورية، فضلٌ في إقناع كثير من الإسلاميين بالانخراط في الإعلان والعمل ضمن صفوفه، وأثار ذلك رعب النظام من هذه التوافقات، وأسرّها في نفسه حتى قام بضرب الجهاز العصبي لإعلان دمشق، على حد تعبير الأستاذ ميشيل.
لولا موقف المعلّم المبجل الصلب في مواجهة النظام، ولولا مقالته الشهيرة الجريئة بعنوان (نعوات وطنية) لما زجّه النظام السوري ثلاث سنوات في المعتقل، في قضية إعلان بيروت دمشق، دمشق بيروت في أيار/ مايو عام 2006، قضاها صابرًا محتسبًا ينوب عن الشعب السوري في الدفاع عن حريته. بعدها بعام ونصف، التحقنا بالأستاذ ميشيل في سجنه، في قضية قادة إعلان دمشق، فكان لنا خير رفيق درب وخير معين طوال فترة السجن، وكانت فيها الروح المعنوية في أوجها، وكم كان يغتاظ النظام من هذا!
وما زلت أذكر اللحظات الأولى لاستقباله الطيّب لي، في الجناح العاشر، بعد أن تم نقلي إليه، ولا تتخيلوا مقدار سعادتي في أن أكون رفيقه في جناح واحد، فكان لقاؤنا اليومي فترات طويلة نبدؤها بالتمارين السويدية التي كان يجبرنا عليها، ثم المشي لساعة نتحدث فيها في كل مواضيع الساعة، وكم استفدت من تجربته وغزارة علمه. ثم زادت البركة بركة، بانضمام الأستاذ علي العبد الله إلينا، فكنا ثالوثًا يغبطنا عليه زملاؤنا. وكان الأستاذ ميشيل أهمّ مصدر للكتب بالنسبة إلينا، في تلك الفترة، وما أروع ما كنا نناقشه في محتوياتها!
ما أصلب موقفه بالانحياز التام إلى ثورة الشعب السوري عام 2011، وإصراره على زوال نظام الاستبداد، فكان من أهم قادة السياسة والرأي فيها وكلمته مسموعة، ولم يألُ جهدًا لنصرة مطالب الشعب في نيل الحرية، وكم بذل جهدًا طوال السنوات العشر من عمر الثورة، في كل المحافل المحلية والدولية، معلمًا الناس المفاهيم السياسية الدقيقة وضاغطًا على المجتمع الدولي لنيل حقوق الشعب، في كل جولات التفاوض التي شارك فيها، ولم تفتر همته يومًا، فقد كان على قناعة تامة بأن ساعة الخلاص قد أزفت، وأنّ الأوان قد حان لكي نشم رائحة الحرية ونستظل بظلالها الوارفة.
كان أول من اكتشف عيوب قرار مجلس الأمن 2254، بمقالاته الثلاث في العربي الجديد تحت عنوان (تراجع في القرار الدولي)، وحددها بوضوح، ومنها أن هذا القرار يدعو إلى إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولاطائفي، وهذا تراجع عن بيان جنيف واحد الذي ينصّ على قيام نظام ديمقراطي، وشتان بين الطرحين، ورأى أن هذا القرار هو بداية التخلي عن إقامة جسم الحكم الانتقالي، فضلًا عن تحذيره من إمكانية أن يُفهم هذا القرار على أنه إقامة حكومة وحدة وطنية، مع بقاء رأس النظام! وهذا ما لا يمكن أن يقبل. كان فهمه عميقًا للنصوص التي تصدر عن الأمم المتحدة، مستفيدًا من خبرته الهائلة بما تعنيه المصطلحات، فكان بالغ الدقة في تحديد مدلولاتها، وسبر مآلاتها.
عتبتُ عليه كثيرًا، عندما استقال من الائتلاف الوطني، وما كان لمثله في كفاحه ونضاله وروحه الرسالية أن يتخلى عن دوره القيادي في المعارضة، فقد كنا أحوج إليه في اللحظات الصعبة الحاسمة، حيث نفتقد الحكمة وسداد الرأي. كان موقفه من الإسلام والإسلاميين إيجابيًا، فقد كان يعتبر نفسه ابن الحضارة الإسلامية والناهل من معينها، وتعاون مع التيار الإسلامي في مواطن شتى، وشكّل مع الإخوان المسلمين في كتلة التجمع الوطني في الائتلاف تحالفًا قويًا، وكان أهمّ مفكر فيها.
صحيح أنه كان يعيب على الإسلاميين بعض تصرفاتهم، وكان قاسيًا، ولكننا نشهد له أنه كان يريد الإصلاح ما استطاع.
كم كانت خاتمته رائعة، بكتابة القيم (من الأمة إلى الطائفة) بأجزائه الثلاثة، وقد قوّض فيه فكرة الأسدية، ولم يبق لها قائمة في أعين الناس. لقد حطم في هذا الكتاب كلّ ما سعى لبنائه النظام الطائفي البعثي من أركان.
هذه كلمات من تلميذٍ له لا تفي بما يستحقه، ولكن عزاءنا أنه سيبقى في قلوبنا في سجل الخالدين.
تلفزيون سوريا
——————-
===============
تحديث 26 نيسان 2021
————————
“وديعة” ميشيل كيلو ووصيته/ سميرة المسالمة
هناك في مكان يتماهى في حدوده مع نزيل آخر اسمه سورية، امرأة هادئة، طيبة، معطاءة، كريفنا السوري. سكنت في قلب ميشيل كيلو، وإلى جواره، نحو ستة عقود، تقاسمت فيها معه سنوات الحب والقهر والاعتقال وألم الغياب، وكلٌّ من مكانه كان يشكل للآخر رافعةً معنوية، وجسر عبور إلى الأمل، والمستقبل الذي يشكله تفاؤلٌ لا حدود له بانتصار حق الإنسان في حياة حرة وكريمة. كانت تلك وديعة ميشيل كيلو، مصدر قوته وعزيمته، ومخزن الحب الذي كان ينهل منه ليقاوم قهراً مستبدّاً، وزنزانة حاكم، وتقلّبات المزاج الشعبوي بين مؤيد ومنتقد، إلى حد أن يوغل بعضُهم سكاكين كلماته المسمومة بين دفء انتقاداته له.
هذه السيدة التي تعتصر ألماً اليوم، تقف إلى جوار جثمانه، وتمشي معه إلى حيث يستقر في أولى محطات رحيله الأخير في باريس، على أمل ألاّ تكون تلك محطته الأخيرة، فإيمانها بأنّ الزوج الراحل ترك مخزوناً كبيراً من تجربةٍ مديدةٍ، ما زال يكتنزها حاسوبه، والأمل أن تمتد له يد المساعدة لتحرّرها وتؤمن وصولها إلى أصحاب الحق فيه من كلّ السوريين، فلدى وديعة كثير من ودائع ميشيل كيلو السياسية والإنسانية، وما أكثرها.
ميشيل الإنسان الذي أستطيع أن أكتب عنه الكثير، والذي أعاد سورية بتفاصيلها إلى بيتنا، منحني، أنا وزوجي، استراحة من غربتنا خلال زيارته لنا في فيينا مكان لجوئنا، بعدما ضاقت فرصنا في الحياة داخل سورية كما هو حال كثيرين من أمثالنا. كان الجدً الذي روى لأولادي الشباب “حكاية ميشيل كيلو الحقيقية” حكاية العصفور الآخر الذي خبروا طيرانه وألوانه واتساع سمائه، على عكس ذلك الطفل الذي غيّب النظام معالم الحياة عنه، فعجز عن الانبهار والتخيّل. صادق ابني الكبير مجد، وتابع أخباره، كتب له الرسائل كما لو أنّه اختصر سنوات الفارق العمري كلّها بينهما ببساطته وتباسطه. ونافس ابني الأصغر حسن، في حسّ الفكاهة والخطابة، وذهب معه إلى أقصى أحلامه ومشاريع مستقبله. علّمني، مع زوجته الرائعة، كيف أبني هرماً من الاكتشافات المستقبلية مع ولديّ، وهو يسرد تفاصيل علاقته مع ابنه حنّا، الشاب الذي تحمل أعباء مواقف والده الوطنية، ومع أحفاده من ابنه أيهم، وابنته شذى.
خسر تراب سورية اليوم احتضان واحدٍ من عشّاقه، وأحد أنبل من عملوا من أجل تحرير الإنسان الذي عاش فوقه، ليعاقب بحرمانه منه حياً في آخر سنواته، وميتاً غريباً في أرضٍ عرفت كيف تصنع له مكاناً بديلاً، يأوي إليه مع عائلته. هو الرجل الذي لم تثنه سنوات الاعتقال داخل زنزانات بلده، ولا مخاوف تكرارها، من أن يستمر في كفاحه من أجل الحرية، من داخل بلده ما أمكنه ذلك، وقد صدق في قوله “أموت من أجله وفي سبيل حرية شعبه”.
وقد فعلها، مات ميشيل كيلو وهو ممسكٌ بسلاح قلمه، يدافع عن وطنٍ يتسرب منَا جميعاً، يضمُر شيئاً فشيئاً، لكنّه على الرغم من ذلك، بقي بين كلماته في وصيته: وطن سوري يتّسع للجميع، وكبير بالجميع منا، عرباً وكرداً وآشوريين وشركس وتركمان، بكلّ تنوعنا ومذاهبنا. لم تغير حروب السنوات العشر خطوط حدود بلده في ذاكرته، وقد آمن بأنّ وحدتنا – نحن الشعب – هي التي تطبع صورة خريطتنا دولةً تخرج من تحت رماد التمزّق، وتعود سورية الواحدة والفريدة.
كسبت باريس اليوم ذلك الوسام السوري الرفيع ميشيل كيلو، وأخذت بين جنباتها جثمان مناضل عنيد، آمن بثوابت ثورات الحرية، وأعلى قيمة الكرامة الإنسانية في فعله وقوله، حتى آخر لحظات صحوه في حياته الممتدة 81 عاماً. منحته فرنسا أمان الإقامة، ومنحها هو عيوننا المتوجهة إليها، وبحراً من دموعنا التي ترافق جثمانه من كنيسة Saint-Pierre-de-Montrouge إلى مثواه “المؤقت” في مدفن Cimetiere parisien de Bagneux، حيث لن يقبل الأحرار من السوريين إلّا أن يكون مثواه الأخير في تراب سورية الحرّة وفي اللاذقية، مهد عشقه الأبدي، وحيث يستحقّ أن يبقى علامة بارزة في صناعة تاريخ سورية الحديثة، حين يبقى الفكر وتزول البنادق.
اختصر ميشيل كلّ ما أراده من السوريين من بعده بوصيةٍ حمّلني أمانة نقلها إلى كلّ العالم، فأودعني رسائله، ووضع لي عناوين ما أراد أن يوضحه، وأهداني ثقته، بأن أكون المؤتمنة على إعدادها، وإرسالها إلى صحيفة العربي الجديد في تأكيد منه على منحي هذا التقدير الكبير من كاتب وسياسي، اختلفت معه في مواقف عدة، لكنّنا اجتمعنا معا في أعمال كثيرة، نسعى من خلالها إلى بناء جسور تواصل وثقة مع كلّ السوريين، وكأنّ اختلافاتنا كانت سبباً لتقاربنا وصداقتنا التي بدأت أولى ملامحها في دمشق 2011 إبّان انطلاقة الثورة. ثم تعثرت، إثر اجتماعاتنا في أولى سنوات انضمامنا إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عام 2013، وعادت لتتعمق عام 2015، ليكون السبب في قبولي تسلم مهمة نائب الرئيس للائتلاف بعد ابتعادي عنه عامين متتالين.
في الأيام الأخيرة، كنت أرسلتُ صورة عن رسالة الأستاذ ميشيل، مرفقة بالوصية التي بعث بها إليّ، والتي نشرتها “العربي الجديد” وهي في الحقيقة الجزء الثاني من المنشور الذي سبقها، ونشر يوم 28 من الشهر الماضي (مارس/ آذار) تحت عنوان “نداء إلى السوريين الأحرار” وقد تضمن أيضاً عبارات قصيرة وعناوين أراد الاطمئنان بأنّه أوصل ما يريد قوله إلى كلّ السوريين، وقد استكملها بما نشر في “العربي الجديد” يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري، تحت عنوان: “إلى السوريين”. وربما يفيد أن أذكر أنّه، بعدما اطلع على النص النهائي قبل نشره، وعلى الرغم من ظروفه الصعبة، انتبه إلى نسيانه الحديث عن فلسطين، فكتب مضيفاً: “لا تنسوا أنّ معركة فلسطين هي أصل كلّ معاركنا، وأنّنا ندفع ثمن هزائمنا فيها”. ثم قال: “لن تتوازن الوصية من دون التأكيد على دور المرأة والشباب والطفل”. هكذا، كان ميشيل حاضراً في كل تفاصيل قضايانا حتى آخر رسالة منه، وهي الرسالة الصوتية، التي كانت نتيجة تواصل بيننا، بخصوص معايدته السوريين لمناسبة حلول شهر رمضان (13 إبريل/ نيسان).
رحل ميشيل عن هذه الدنيا، لكنّه ترك الكثير مما يمكن أن نكتبه عنه وله وحوله، وفي نقده، وفي التوافق معه، ما يؤكد أنّنا أمام حالة سياسية وإنسانية جامعة، لا يمكن مقارنتها بأحد آخر، سوى بالحالة الشعرية لنزار قباني بأنّه رحل وبقي الكلّ حوله بين معارض ومؤيد يتحدّثون عنه، ويضعونه مجالاً ومكاناً للمقارنة، واقتباس ما يمكن أن يعيننا على وصف واقع ذهب أو حاضر أو قادم.
العربي الجديد
————————–
ميشال كيلو..سيرة لبنانية مبتورة/ ساطع نور الدين
لميشال كيلو سيرة لبنانية لم تروَ، تبدأ مع توريث الرئاسة السورية، قبل إحدى وعشرين سنة، ولا تنتهي بالغربة النهائية عن دمشق وبيروت، وعن ربيعهما الذي كان يحلم بأن يكون مشتركاً، فترجم ذلك الحلم الى نص بيان ثم الى مشروع، دار به بحماسة لا توصف، بلغت حد التهور، على الاحياء والمقاهي والمجالس الدمشقية والبيروتية على حد سواء، كما كان يفعل في بدايات عمله السياسي والثقافي.
لا يمكن لأي إستعادة للسنوات الخمس الاولى من عمر التوريث السوري، ومن الترقب اللبناني، ان تغفل دور ميشال كيلو، الذي كان يتردد على بيروت، باحثاً عن أدلة لبنانية على رغبة بشار الاسد بإصلاح نظام والده، فلم يجدها، فعاد أدراجه الى دمشق ليجد ان باب السجن قد فُتح له، ولسواه ممن حاولوا إستكشاف المستحيل.
كان ميشال في بيروت يسأل عما إذا كان اللبنانيون قد لمسوا أي تغيير في سلوك النظام الامني السوري في لبنان، فكان الجواب يأتيه على الفور، بأن ذلك النظام أصبح متوتراً أكثر من ذي قبل، وزاد من تغوله في الهيمنة على القرار اللبناني، وفي رفع قيمة الخوات التي يجبيها من لبنان، وكأن ضباطه ورموزه تفلتوا من قيود سابقة، او لعلهم شعروا بأن الوقت ينفد للحصول على آخر الغنائم من المغارة اللبنانية.
مع ذلك، لم يفقد ميشال الرجاء بأن ربيع دمشق آت لا محالة، وظل متمسكا بالبيان الاول، إعلان دمشق ، ثم إعلان دمشق _ بيروت، كوسيلة لإختبار جدية النظام الاسدي في وعود الاصلاح، لا سيما من خلال المطالبة المباشرة والمتكررة بالمزيد من الحريات، او بالاحرى بتخفيف قبضة النظام الامني على الشعب السوري، فسمع من المسؤولين السوريين تشكيلة واسعة من الردود بينها ان الاسد يحتاج الى المزيد من الوقت لكي يثبت أقدامه، او انه يواجه فيلة النظام الذين لن يسمحوا له بالاقدام على مثل هذه الخطوة..
عبارة “النظام الامني اللبناني السوري المشترك”، التي أطلقت في ربيع بيروت الاول العام 2005، كانت مستعارة من مصطلحات ميشال كيلو السورية المستحدثة، التي كانت تنشد فعلاً إصلاح النظام الاسدي بشكل يحمي سوريا من الخطر، الآتي من الشرق، من العراق الخاضع للإجتياح الاميركي، ومن الغرب، من لبنان الذي طالت معاناته مع التدخل العسكري والاستخباراتي السوري في شؤونه الداخلية. شهد ميشال الكثير من الجدل الذي أثير في لبنان حول الوجود العسكري السوري وما اذا كان “ضروريا ومؤقتا”، حسب الفتوى التي توصل اليها الراحل رفيق الحريري في اعقاب القرار 1559 الشهير لمجلس الامن الدولي، الذي كان جوهره وبنده الرئيسي ينص على المطالبة الصريحة بإنهاء ذلك الوجود.
لكن ميشال كان يومها متوجساً أكثر من شريكه اللبناني في صياغة اعلان دمشق_ بيروت، الشهيد سمير قصير، وكان أشد خوفاً من سلوك النظام الاسدي ومن حلفائه اللبنانيين، الذين رفضوا بشدة خروج سوريا من لبنان، واقترحوا يومها بديلاً هو اعادة الانتشار الى البقاع.. وكانوا مستعدين، حسب النكتة الشائعة في ذلك الوقت، الى رمي أنفسهم أمام الدبابات السورية لمنعها من الانسحاب.
كان إغتيال رفيق الحريري، إيذانا ببدء الانقلاب الامني على القرار 1559، وبدء الحملة المضادة على رموز ربيع دمشق، الذين فتحت امامهم أبواب السجون والمعتقلات السورية، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ النظام الاسدي، الذي كان في ما مضى معنياً فقط بتصفية حركة “الاخوان المسلمين”، الى أن جاء الوريث وشن حملته الخاصة على غير الاسلاميين.
كان الاحساس العام يومها، بأن كل شيء قد إنتهى في بيروت وفي دمشق معاً، وطويت مرة والى الأبد فكرة الاصلاح والتغيير، التي لاحت بشكل عابر في سماء سوريا في السنوات الخمس الاولى من ولاية الوريث، بانتظار فرصة تاريخية أخرى..توافرت بعد ست سنوات في مستهل الربيع العربي، الذي كانت معالمه السورية الاولى ترجمة لما كان ميشال وأترابه يطالبون به من حريات واصلاحات. لكن الشعب السوري سبق جميع التشكيلات والمحاور الداخلية، وبينها محور اعلان دمشق وتجمعه الديموقراطي، ملحاً على مطلب الاصلاح، الذي أرفق هذه المرة بالعبارة الخالدة “إجاك الدور يا دكتور”.. وهو ما رد عليه الدكتور وفريقه بالعودة الى وصايا والده وموروثاته وتجاربه: القليل من الحوار مع رموز المرحلة السابقة، والكثير من البطش بالرموز الواعدة وتنسيقياتها الوليدة.
وما أن بدأ شلال الدم ينهمر بغزارة، حتى شعر ميشال باليأس التام، من مستقبل سوريا ولبنان، من دون أن يتخلى عن دوره كمرشد للتنسيقيات المحلية، وراعٍ لتجربتها الشابة، وعن موقعه في العمل، ولو من داخل السجن، لإنتاج بدائل سلمية مدنية ديموقراطية للنظام.. فكان ورود إسمه في مختلف المجالس الوطنية والهيئات السياسية التي شكلت في السنوات الاولى من الثورة، من لزوميات أي تجربة ثورية جدية..مع العلم بأنه كان من اوائل الذين شعروا بان الاميركيين يكذبون، والفرنسيين يخدعون، والعرب يتناحرون على مصير النظام الاسدي، وكان من أوائل الذين أدركوا أن الروس هم أخطر ما طرأ على المستقبل السوري، ومن أوائل الذين سجلوا أن الايرانيين هم أسوأ ما يمكن أن يحصل لسوريا. وكان هذا التقدير كافياً لاستنتاج ميشال ان النظام الاسدي عاد ثلاثين سنة الى الوراء، متكئاً على حليفيه الأولين.
ما بين السجن والمنفى، ظل ميشال على صلته ببيروت، متمسكاً بإصرار عجيب على فكرة أن الثورة لا تكون إلا على النظامين، اللذين صمدا معا ولن يسقطا الا معا، حتى بعدما ورث حزب الله صلاحيات وأدوار النظام الامني اللبناني والسوري المشترك، وأحال لبنان الى مساحة معادية لكل معارض سوري، مهما كان مسالماً.. ثم الى بيئة خطرة لا يجرؤ أي معارض سوري حتى على زيارتها، ولو في السر.
عندها انقطع ميشال عن بيروت، لم يبق له فيها سوى بعض الذكريات غير المروية، وغير المدونة، التي حاولت “المدن” مطلع الشهر الماضي، اعادة سردها، من خلال دعوته الى كتابة نص اسبوعي، يبدأ بتلك التجربة اللبنانية السورية غير الرسمية الخاطفة التي لم تدم سوى بضع سنوات، ويدخل بل ويتدخل في نقاش الشأن اللبناني الذي لا يجوز ان يغيب الى هذا الحد عن إهتمام رموز المعارضة السورية، مهما تغيرت الاولويات وتباعدت اللقاءات.
طلب ميشال مهلة شهرين فقط لانجاز كتابه عن الثورة السورية، لكنه، للمرة الاولى، أخلف الوعد!
المدن
————————–
سوريا… عن هؤلاء الراحلين الذين لا نعرفهم/ إيلي عبدو
نجد ما نتمناه لبلدنا المتخيل، بمن يرحل من نخب ومعارضين، فتسبغ الصفات تلو الصفات، ويُغرّب من يرحل عن نفسه وسيرته، وكذلك سوريا.
من يتتبع الصفات التي أُسبغت على المعارض السوري الراحل، ميشيل كيلو، يلحظ أنها تحتاج إلى أكثر من ميشيل واحد، ليمتلكها، ربما عشرة ميشيلات، 20 أو أكثر. حكايات كثيرة سردت ضمن مقالات صحافية عن مواقف الراحل النبيلة، من قصة العصفور الشهيرة مروراً بالحماسة لمساعدة الناس بالأموال و”مسح دموع الحزانى”، وصولاً إلى العناية بالمرضى. أما وصيته التي كتبها قبل وفاته، فهي “ميثاق وطني للمرحلة المقبلة… وعقد اجتماعي”، وندرة إصداراته، تعود إلى أنه “مؤدلج يومي” و”أستاذ جيل”، عدا أن “خطايا” الرجل في السياسة هي “خطايا عاشق” وقع في حب بلده، ووجب تكريماً لذكراه “تنكيس أعلام الثورة”. أما ديانة الراحل فهو لم يعرفها إلا حين صار بالعشرين.
“المؤدلج اليومي” و”العاشق” و”ماسح الدموع”، و”أستاذ الجيل” تختلط مرجعياتها، بين الشاعري، حيث تفسير السياسة بالشعر للقفز فوق الأخطاء، والتذاكي المعرفي والإسقاطات المنزوعة من سياقها لتبرير عدم وجود مؤلفات، يُعتدّ بها للراحل. واختلاط المرجعيات، واستخدامها كأدوات تعمل بالضد من معانيها، وتفرّغ بعضها من بعض، تفسّر الابتعاد من سيرة الراحل الحقيقية واختراع أخرى متخيلة، يعمد صنّاعها للابتعاد من الدقة، فتجعل من كيلو “قديساً” يتكرس موقعه الجديد، مع الرجم الذي يناله من أنصار النظام والانتقادات من بعض الأكراد. هكذا تستبدل الموضوعية والعلمية والمهنية، بالعاطفة والشعر والحزن والرثاء والعلاقات الشخصية، لتصنع للفقيد صورة مختلفة عن الواقع، ونصبح حيال ميشيل آخر غير الذي توفي، صفاته تفيض عنه.
وكيلو ليس الوحيد، من الراحلين، الذي نال صفات غير دقيقة وموضوعية، من خارج سيرته، فقد سبقه المخرج حاتم علي، والممثلة مي سكاف، وجزئياً عبد الباسط ساروت. إذ يمكن القول، إننا أمام تقليد سوري، يخترع راحلين غير الذين يرحلون، عبر تضخيم سيرهم وإسباغ الاستثناءات عليهم.
هكذا تستبدل الموضوعية والعلمية والمهنية، بالعاطفة والشعر والحزن والرثاء والعلاقات الشخصية، لتصنع للفقيد صورة مختلفة عن الواقع، ونصبح حيال ميشيل آخر غير الذي توفي، صفاته تفيض عنه.
ومردّ ذلك، على الأرجح، النظر إلى الراحلين من زاوية التمني لسوريا، أي أن من يرحل انطلاقاً من انخراطه في الشأن المعارض، يصبح جزءاً من حالة مشتهاة لسوريا الحرة غير المتحققة، يمتزج خاص الراحلين بعام ما نحلم به لبلدنا. هزيمة هذا الحلم يتم ترحيلها إلى من يموت، فتسبغ عليه صفات استثنائية، تعالج، ما ضاع وسقط، من حلم سوريا الخالية من الاستبداد. وعليه، نعوّض بكيلو وسكاف وعلي والساروت، وغيرهم، ما فاتنا من هدف لم يتحقق.
صحيح أن ذلك يحصل عبر استنفار العواطف واستخدام الشعر ولغة الرثاء، لكنه يحصل أيضاً، بوعيين، أحدهما عشائري والآخر ديني. فالعشيرة لحظة موت أحد أبنائها، تسبغ عليه المدائح بوصفه امتداداً لها عملاً برابطة الدم، حتى لو كان الراحل بعيداً من العشيرة، أو فرداً اختار حياة بمعزل عن نسبه، العشيرة تستعيده لحظة موته، وتعيده إلى أصله، فتخترعه من جديد عبر صفات ليست منه. والأديان أيضاً، تعمل على قاعدة “اذكروا محاسن موتاكم”، وتجتزئ من سيرتهم ما يجعلهم أقرب إلى الجنة منهم إلى النار، حتى لو كان المتوفي غير مؤمن أو بعيداً من طقوس العبادات، الدين يستعيده، من “هرطقته” و”كفره”، ويسلك مسار العشيرة في إعادته لأصله واختراعه مرة أخرى. الطرفان يستعيدان إذاً، من يرحل، من أجل الحفاظ على ما يتخيلونه، من نسب وميتافيزيق.
والحال، فإن الوعيين، مترابطان مع تخيل سوريا الحرة، الذي يحصل بعناصر ما قبل موضوعية تتقاطع مع أدوات العشيرة والدين وربما العائلة والإيديولوجيا، بحيث نجد ما نتمناه لبلدنا المتخيل، بمن يرحل من نخب ومعارضين، فتسبغ الصفات تلو الصفات، ويُغرّب من يرحل عن نفسه وسيرته، وكذلك سوريا.
درج
—————————-
ميشيل كيلو حاضرًا بيننا/ يوسف سلامة
على طول الإلفة والمودة، لم أشعر يومًا بأن هذا الرجل العظيم هيّاب من الموت أو جَزع أمامه. كيف ذاك وهو الذي ضحى بآجال مديدة من العمر، في كل مقارعة ومواجهة مع الاستبداد، سجينًا في أقبية النظام، محرومًا من العائلة والولد والصديق، صابرًا على كل ما يلقاه من عنت وأذى وانتهاكات مارسها النظام السوري في سجونه.
ومع ذلك، فقد كان ميشيل كيلو في الفترة الأخيرة من حياته وجلًا وحزينًا، لأنه لم يشهد انتصار الثورة، وأيقن أن التراب السوري لن يكون مثوًى أخيرًا لروحه وجسده، على الرغم من علمه بأنه سيشيع في مدينة يعرف قدرها الحضاري، ويحترم ميراثها السياسي، ولكنها مع ذلك ستظل في نظره أرض غربة لروحه ونفسه، بل وحتى لجسده.
لم يكن الموت الشخصي ليعني الشيء الكثير في نظر ميشيل كيلو، وما ذلك إلا لأن مستقبل سورية والسوريين قد كان شاغله الأكبر. فالقراءة الدقيقة لوصيته تكشف أن النصوص المُركزة والقصيرة التي اشتملت عليها تشي بأنه قد كان منصرفًا بكليته إلى التفكير بالحياة والدفاع عنها، بوصفها حقًا يعلو فوق كل الحقوق. وبديهي أن طريقة كهذه في التفكير لا يمكن إلا أن تكون تعبيرًا عن قيمة أخلاقية رفيعة تتمثل في نزعة غيرية، فحواها الإيمان بأن على المرء مسؤولية أخلاقية، من واجبه أن يؤديها اتجاه الأحياء حتى بعد رحيله عن عالمنا الذي يكافح فيه البشر لانتزاع حقوقهم والدفاع عن كرامتهم. فَراحُلنا لا يرى أن رسالته تتوقف عند موته، كما أنه لا يرى أن مسؤولياته الأخلاقية تنقطع بانقطاع حياته الشخصية. فالتزامه بالمصير السوري لا يحده حد وغير مقيد بقيد. هذا الالتزام بالمستقبل السوري -وطنًا وشعبًا- حتى في ما وراء الموت، تعبير عن إيمان عميق بأن المجد للإنسان. ولكن هذا المجد ليس مجدًا مجردًا أو قيمة غير متعينة في تجليات وتعبيرات محددة وملموسة في الزمان والمكان. وهذا مانعنية بقولنا: (ميشيل كيلو حاضرًا بيننا). ويتحقق هذا الحضور من خلال الصورة التي يرسمها للإنسان السوري، في تضاعيف وصيته، وقد انتصرت ثورته، واستعاد حريته وكرامته، التي هدرها الاستبداد واستخف بها زمنًا طويلًا.
ومن أنصع ما يدلّ في وصيته على أنه حاضرٌ بيننا سلسلة من المواقف النقدية التي يسوقها بكل الاحترام لجميع السوريين، متفهمًا للعقبات والصعوبات التي مرّوا بها، والتي سيمرون بها بعد رحيله أيضًا، إلحاحه الشديد على مفهوم (الوطن والوطنية). ففي نظره لا بدّ أن تكون الأولوية للوطن على المصالح والأيديولوجيات. وقهر الاستبداد ذاته لا سبيل إليه دون إطار وطني يوحد الكفاح الذي لا سبيل غيره لقهر الاستبداد والتحرر منه. بل إن راحلنا ينطق بكلمات لا تخلو من مفارقة، عندما يشرط ولادة الشعب السوري الواحد بنظر الجميع إلى الجميع، انطلاقًا من معايير وطنية موحدة لا تفرق بين قوم وقوم أو بين دين ودين أو بين متدين وغير متدين. فعندما تحضر المواطنة، يتحول كل ماعداها من عناصر وتباينات إلى عوامل ثانوية، في مقابل ولادة الشعب الواحد.
قد تكون أقوى التعبيرات التي انطوت عليها وصية راحلنا الكريم، وهي تشهد على حضوره بيننا، نزعاته السياسية القوية المتمثلة في دفاعه عن الحرية الإنسانية. فما لم يكن الإنسان حرًا، فكيف له أن يعبّر عن وجوده وأن يكشف عن إمكاناته في إعادة بناء الحياة وتطوير البيئة التي تسمح للإنسان بالارتقاء بمقدرته على الخلق والإبداع، من خلال استنباط أشكال غير مسبوقة للفكر والعمل على حد سواء.
وليس ثمة شك في أن عقبات كثيرة تقف في وجه الحرية وتحاول تعطيلها. ومن هذه العقبات ما هو اجتماعي وما هو طبيعي. وقد أثبتت التجربة الإنسانية عبر العصور قدرة محدودة للبشر على تخطي هذه الصعوبات، على نحو يختلف من أمة لأمة ومن ثقافة لأخرى. وترجع أهم هذه الصعوبات إلى أن (الاستبداد السياسي) قد ظل دومًا العقبة الكأداء التي تواجه الحرية الإنسانية. ويكاد يكون التغلب عليها هو الشرط الأشد أهمية، للتمتع بكل أشكال الحرية وصورها المختلفة. ولم تنعم الأمم التي فشلت في تخطي هذا النوع من الاستبداد إلا بأقدار محدودة من الحريات. وفي مقابل ذلك، فإن كل أمة نجحت في تخطي هذه العقبة قد تمكنت من تحويل الحرية إلى أسلوب في الحياة غير خاضع لأي قيد تقريبًا. من هنا جاء إلحاح راحلنا على أن الحرية قيمة لا تتجزأ مقابل الاستبداد. فإما الحرية وإما الاستبداد، ولا وسط بينهما. وبعض الحرية ليس بحرية بكل تأكيد.
وفي ضوء التصورات السابقة، لن يتأتى للسوريين أن يحيوا حياة الحرية إلا إذا نجحوا في تخطي عقبة الاستبداد، والدخول في (ملكوت الدولة) التي لا بد أن تكون دولة الجميع. ولكي تكون كذلك، يتعين عليها أن تكون بعيدة عن تبني هوية محددة. وهذا يعني أن الدولة حيادية ومحايدة من الناحية الأيديولوجية والقومية والدينية، وبذلك فقط تكون دولة للحرية من ناحية، ودولة ترعى المصالح العليا للشعب بصرف النظر عن الخصائص التي تتمتع بها الجماعات المختلفة التي يتكون منها هذا الشعب. ذلكم هو الهمّ الأكبر الذي انشغل به ميشيل كيلو طوال حياته. ولم يزل هذا الشاغل مستمرًا في الهيمنة عليه حتى بعد مماته. ولم يكن الأمر كذلك إلا لأنه حاول أن يقترح كل ما من شأنه أن يوفر للسوريين مسارًا آمنًا نحو المستقبل، وفقًا لما رآه وتصوره. وسواء أَقَبِلَ المرء هذه التصورات أم رفضها، فالأمر الذي لا شك فيه هو أن الرجل قد فعل كل ما هو ضروري ليظل حاضرًا بيننا، مع المتفقين معه، من حيث إنه حاضر حضورًا إيجابيًا في أفكارهم، ومع المختلفين معه، من حيث إنه قد وضع رهانًا إيجابيًا في مقابل رهانهم السلبي. والتاريخ وحده هو الذي سيفصل بين الجميع. ولكن تبقى الحقيقة التي لا شك فيها هي أن ميشيل كيلو قد ظل حاضرًا بيننا، على اختلاف اتجاهاتنا ومذاهبنا نحن الأحياء.
مركز حرمون
———————-
في وداع الجميل ميشيل كيلو/ مازن عدي
اليوم، نودعك أيها الجميل يا عاشق الحرية.. مسيرتك خلال نصف قرن من الكفاح والعمل الثقافي والسياسي والحضور الإعلامي تتحدث عنك.
يصعب عليّ الكتابة عن شخصية عامة مميزة، تربطني بها علاقة صداقة عمرُها أكثر من أربعة عقود، حزن عميق يسيطر علي، الإحساس بخسارة رفيق دربٍ عشنا معًا محطات مهمة من تاريخ سورية، خاصة المرحلة السريّة في مواجهة الاستبداد في عهدي الأسد الأب والابن.
كان لقائي الأخير معه قبل شهرين، في مسكنه في منفاه الاختياري باريس، بحضور زوجته، وتحدثنا في أمور كثيرة تداخل فيها الخاص بالعام، أخبرني بمشاريع كتبٍ يحضّر لها، وأهداني كتابه الذي صدر حديثًا (من الأمة إلى الطائفة/ سورية بين حكم البعث والعسكر)، وقد وقّعه بعبارة مؤثرة (إلى صديقي رفيق العمر والنضال..)، كان كعادته يطلعني قبل النشر على قسمٍ من أعماله، وربما يرسلها إلى بعض أصدقائه المقربين. مع بداية إصابته بفيروس كورونا، تحدثنا طويلًا عبر الهاتف، وأراد أن يعرف تجربتي في تجاوز هذا المرض اللعين، قبل ثلاثة أشهر من تاريخه. فقدّمت له استخلاصاتي وتمنيت له الشفاء وقهر المرض. تواصلنا طوال مدة إقامته في المشفى، وكان آخر ما أرسله إليّ كلمات مكتوبة كفقرات، وكذلك إلى بعض الأصدقاء، ونُشرت كوصية له. كانت معنوياته عالية، وعاش لحظات جميلة من مشاعر الاحتضان الكبير من أصدقائه ومحبيه، وأدرك حجم الاحترام الذي يكنّه له غالبية السوريين حتى المختلفين معه.
تعرّفي الأول إلى الراحل ميشيل كان في النصف الثاني من السبعينيات، في بيته في دمشق، حيث زرته برفقة صديق مشترك. كان حديثه ممتعًا ومركزًا، وأعترفُ أنه بهرني بطريقة عرضه لأفكاره ووجهة نظره، كنظم لا حشو فيه، كانت لديّ فكرة عامة عن طروحاته، لكني تيقنت أني تعرفت إلى مثقف عقلُه منفتح على عالم الإنسان، ومجتهد في تحليلاته، ومفعم بالروح الوطنية.
توطدت العلاقة بيننا، بعد خروجه من سجنه الأول الذي دام نحو سنتين، على إثر حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت حوالي 250 شخصًا من كوادر الحزب الشيوعي السوري/ المكتب السياسي، ولم يكن ميشيل كيلو عضوًا منظمًا في الحزب، ضمن الهيكلية التنظيمية، لكن دوره الفكري السياسي لا يقلّ عن دور أي قيادي في الحزب، حيث كانت له إسهاماته ومشاركاته، وكانت السلطات الأمنية تعدّه خصمًا عنيدًا يجب إسكاته، لأنه يملك مساحة تأثير واسعة خاصة في القطاع المثقف، وسعت هذه السلطات إلى طمس الطرح الوطني الديمقراطي الذي بشّر به الحزب والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك النقابات المهنية، وهذا الخط الوطني الديمقراطي يُلغي شرعية حكم العسكر ومقولة الحزب القائد، ويقوض أركان النظام الشمولي الاستبدادي.
كان التحذيرُ شديدًا إلى ميشيل كيلو، عند إخلاء سبيله، جاء على لسان حافظ الأسد بالتهديد بالقتل، إذا تابع نشاطه المعارض. من هذه الزاوية، أَكْبرت بميشيل كيلو شجاعته في المبادرة بالاتصال بي، وكنت في تلك الفترة، في حالة توارٍ في دمشق، إذ كنتُ مطلوبًا لأكثر من جهاز أمني، وفي موقع القرار في قيادة الحزب، بعد اعتقال معظم قادة الحزب في ذلك الحين: رياض الترك وعمر قشاش وفايز الفواز ومنذر الشمعة، وكان شرطه الوحيد ألا يعرف أحدٌ بالعلن عن هذه العلاقة.. وفعلًا، استمرت الأمور سنوات، ولم يعلم بهذه العلاقة بعد مدة سوى الصديق المشترك عبد الله هوشة، الأمين الأول الأسبق لحزب الشعب الديمقراطي السوري (الحزب الشيوعي/ المكتب السياسي سابقًا).
في تلك السنوات، كان يقدّم رأيه ومشورته، ويسهم في تحرير مواد جريدة الحزب المركزية في ذلك الحين (نضال الشعب)، وكذلك في مواد سياسية داخلية يجري تداولها بين الأحزاب الخمسة للتجمع الوطني الديمقراطي، ثم قرر الخروج إلى فرنسا ليمارس نشاطه بهامش من الحرية. كان لديه مشاريعه الثقافية التي تخدم قضية التغيير الجذري الديمقراطي والمشروع الحداثوي النهضوي.. كتاباته في الصحافة اللبنانية أو الفلسطينية لم تتوقف. عكف على ترجمة العديد من الكتب المهمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية، وهي كتب تخدم الفكر السياسي والمفاهيم الحداثية وتجربة النهضة والثورات في أوروبا. كان من أبرزها (لغة السياسة) و(الإمبريالية وإعادة الإنتاج) و(الديمقراطية الأوروبية) و(الوعي الاجتماعي).. وخلال تلك الفترة، أنتج كتابًا تحليليًا في بنية النظام السوري، بقي مطبوعًا على ورق الآلة الكاتبة، وأصدر جانبًا مما تضمنه فيما بعد، في كتابٍ نُشر في دار مدبولي في مصر بصيغة حوارات حول سورية، سؤال وجواب، باسم مستعار (محمود صادق).. بالإضافة إلى أعمال أدبية من وحي تجربته في السجن.
تمتنت علاقتنا أيضًا من خلال تفاعلنا وتأثرنا المشترك بالمفكر الكبير إلياس مرقص، وبمنهجه النقدي، إذ يرتبط به ميشيل بعلاقة تاريخية، وكنتُ على تواصل معه في السنتين الأخيرتين قبيل وفاته عام 1991. علاقة ميشيل بالفكر والثقافة كانت الأساس في توجيه نشاطه السياسي، كان يعمل بمنظور تاريخي، وكانت ثقته كبيرة بقدرات الشعب السوري على التغلّب على كل قوى الاستبداد.
مع بداية التسعينيات، عاد ميشيل إلى سورية ليستقر فيها، ولم ينقطع التواصل بيننا، سواء عبر الرسائل أو من خلال اللقاء المباشر.. وبعد حرب الخليج الأولى عام 1991، بات متحمسًا للتوجه الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي، في سعيه لانتزاع شرعية علنية في النشاط وفرضها كأمر واقع، بالرغم من حملات الاعتقال التي طالت عشرات من كوادر التجمع الوطني الديمقراطي، وكان دائمًا مواكبًا لكلّ ناشط معارض، وكان يشارك أحيانًا في لقاءات مع بعض قيادات التجمع، أو في افتتاحيات نشرة الموقف الديمقراطي (1991-2011) التي يصدرها المكتب الإعلامي للتجمع، وهو صاحب الاقتراح بتسمية المنتدى الذي أحدثه (التجمع)، ورعاه في نهاية عام 2001 خلال ربيع دمشق، باسم منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي.
كان دور ميشيل كبيرًا ضمن المجموعة الفاعلة من المثقفين السوريين في ربيع دمشق: بيان المثقفين، وبيان الألف ونشاط المنتديات، وفي تشكيل لجان إحياء المجتمع المدني، وفي إعلان دمشق، ثم في إعلان بيروت دمشق، الذي اعتُقل على إثره عددٌ من المثقفين والناشطين الحقوقيين، كان هو من أبرزهم، وكذلك المحامي أنور البني، ومرة أخرى يدخل ميشيل كيلو السجن، لكن في عهد بشار الأسد، ويقضي ثلاث سنوات كاملة في سجن عدرا.
وجاءت الثورة لتشكّل مرحلة جيدة في عمله السياسي والوطني، وربما تعدّ الأكثر تعقيدًا وأكثر إشكالية. ولستُ بمعرض سرد أو تقييم الدور الكبير الذي لعبه ميشيل كيلو، خلال مسيرة طويلة كنتُ شاهدًا على معظمها، سيُكتب عنها الكثير، لكن المحزن في الأمر هو الخسارة الوطنية لغيابه المبكر. فعلى الرغم من تقدّمه بالسنّ، كان يتمتّع بحيوية ونشاط وأداء عقلي وسياسي متميزين، وكان يحاول الاستفادة من تجربته وأخطائه وأخطاء المعارضة والثوار الحقيقيين. وظلَّ يقدّم ويعطي ويجتهد ويبادر، بالرغم من الاستعصاء الشديد في الأوضاع السورية، بعد انقضاء عشر سنوات على انطلاقة الثورة، وتخاذل المجتمع الدولي عن واجباته وقراراته ووعوده في حماية الشعب السوري والدفاع عن المنظومة القيمية لحقوق الإنسان المُقرّة من الأمم المتحدة.
محبّو ميشيل كيلو وخصومُه كلاهما يعترفون بحضوره القويّ والمؤثر، ليس فقط لسرعة بديهته وذاكرته القوية وطلاقة لسانه بل لقدرته المستمرة على المبادرة واقتراح الحلول، سعيًا منه لخروج السوريين من مأساتهم واستعادة الوطن وبناء عقد اجتماعي جديد، يحدد الشعب فيه خياره الديمقراطي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة.
وبالرغم من عقلانيته الشديدة، كانت العاطفة وتأجج المشاعر تطغى على شخصيته، كان وطنيًا بامتياز، معطاء بامتياز، شديد الحماسة.. وكانت هذه الخصال المعبّرة عن الطيبة والصدق توقعه في الخطأ أحيانًا، مع من احترف الخداع، كما توقعه في تقديرات فيها من المبالغة ما يجعل خصومه يتربصون له تجاه أي هفوة.. وهو في الدفاع عن قناعاته كان جسورًا، ولا يخاف من فتح الجبهات الفكرية أو السياسية، ويشعر باستقلالية كبيرة، ولديه نزعة تمردية غير قابلة للتأطير.. من يعرفه جيدًا عن قرب لا يمكن إلا أن يحبّه.. قد ينحني للعواصف، وقد يقع في الأخطاء، لكنه يعترف ويقول: البشر خطاؤون.. ومن لا يعمل لا يخطئ. كيف لا وهو بمفرده ورشة عمل… لقد أحبّه السوريون، وصدق من رثاه: “لو كانت البلاد بلادنا لمشت دمشق في جنازتك..”، و”بكتك سورية”.. وإننا نودع جثمانك الآن وفي القلب ألف غصة.. وداعًا أيها الجميل.
مركز حرمون
————————
==================
تحديث 27 نيسان 2021
——————————
عن مواطن اسمه ميشيل كيلو/ أيمن أصفري
لم أكن قد التقيت ميشيل كيلو في حياتي عندما اندلعت الثورة السورية. كنت أقرأ له مقالات وتصريحات، وكنت معجباً بأفكاره وصموده، وتضحياته لبناء سوريا دولة ديمقراطية ومدنية وتعددية؛ أفكاره التي قادته للمعتقل مرات عدة، آخرها عندما وقّعَ مع معارضين سوريين آخرين على بيان حول تحسين العلاقات السورية-اللبنانية في أيار (مايو) 2005.
بعد مرور سنة على اعتقاله، وتحديداً في حزيران (يونيو) 2006، التقيت ببشار الأسد. كان هذا اللقاء الثالث المنفرد بيننا بعد لقاءين عامي 2002 و2003، حيث تحدثنا عن الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال «ربيع دمشق». قبل ذلك، حضرتُ مع الجالية السورية اجتماعاً مع الأسد لدى زيارته لندن في نهاية 2001. وقتذاك، كنت من الداعمين له: رئيس شاب، يتكلم عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتزوّج أسماء الأخرس التي كانت تعيش في لندن وبدت أنها عصرية بثقافتها الغربية. كما كنت من مؤسِّسي الجمعية السورية-البريطانية.
عندما ذهبت إلى دمشق للقاء الأسد في العام 2006، حظيت باستقبال رسمي، ثم توجّهت للاجتماع به في قصر الشعب، على عكس الاجتماعين السابقين اللذين جريا في جبل قاسيون.
في البداية، كان الاجتماع ودياً ودافئاً. سألني عن لندن، وعن رأيي بالسفير السوري هناك سامي الخيمي، قلت له إن الخيمي ممتاز ومحبوب من الجالية السورية. فردّ علي: «نعتبر أن أي رجل أعمال ناجح هو سفير، وأنت لك دور أهم من السفير كي تعمل على توضيح صورة سوريا وتتكلم عما يحصل فيها أمام الرأي العام البريطاني». هنا، تشجّعت وعرضت مقالاً في صحيفة هيرالد تربيون كنت قرأته في الطائرة في طريقي لدمشق، عن اعتقال ميشيل كيلو بعد توقيعه البيان عن العلاقات السورية-اللبنانية. قلت: «كسفير، يصعب عليّ أن أدافع عن اعتقال صحفي أو مدافع عن حقوق الإنسان بسبب مقال أو بيان». فوراً تغيّر جوّ الاجتماع، وانتقد ميشيل قائلاً إنه «عميل لتيار المستقبل ولدى المخابرات أدلّة على ذلك».
رددت: «هذا كلام المخابرات، ربما هناك كلام ثانٍ، ودكتور أنت كنت تتحدّث عن الإصلاح والتعددية»، فردّ بما معناه أن ثمة فلتاناً في البلد، وأن الديمقراطية تحتاج إلى أجيال، وأنني أعيش في برجي العاجي في الغرب ولا أعرف حجم المؤامرات والضغوطات التي تتعرّض لها سوريا. وطلب مني التركيز على الاقتصاد وليس على السياسة، التي لها أهلها.
وبعد سنتين، التقيت بمسؤول سابق في أوروبا، وقال لي «الرئيس لا يزال مزعوجاً منك»، وإنني لو زرت دمشق فلأذهب لأصدقائي مثل ميشيل كيلو، الذي كان قد أُطلق سراحه حينها. وقتذاك، أيقنت أن الرغبة في الإصلاح غير متوفرة أبداً.
في الواقع، لم أتحدث مع ميشيل كيلو إلى حين خروجه من سوريا، إذ دعمنا سوية الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني، ثم عقدنا اجتماع الائتلاف الوطني السوري في باريس، قبل إعلانه في الدوحة في العام 2012، وأسّسنا المنبر الوطني الديمقراطي في العام 2013.
أذكر كيف اتّصل بي مسؤول عربي لأتوسّط لدى ميشيل كيلو ليتوقف عن انتقاد تركيا، التي كانت تستضيف اجتماعاً للمعارضة شارك فيه كيلو وانتقد بشدة الإخوان المسلمين والمتطرّفين وأسلمة الثورة. كما وجّه انتقاداً حاداً لسياسة أميركا وامتناعها عن دعم الثورة في اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا بحضور وزير الخارجية جون كيري.
في كل الاجتماعات، كنت ألاحظ شجاعة ميشيل كيلو وعدم توانيه عن قول الحق ومناهضة الاستبداد والعمل لما فيها خير الشعب السوري. كما أنه كان صادقاً ومحبوباً حتى ممن لا يعرفه. وكنت شاهداً في العديد من المرات على عطائه وكرمه في التبرّع للسوريين والعمل على مساعدتهم، رغم ضعف إمكانياته المادية.
مثّلَ ميشيل كيلو وجدان الثورة السورية، وآمن بمبدأ المواطنة قبل العرق والطائفة والدين، وعبّر بكل إخلاص عن التيار الوطني والمدني والعصري في سوريا. ناضل وتعرّض للاعتقال، مرّات ومرّات، دفاعاً عن مطالب الحرية والكرامة.
قال لي أكثر من مرة إنه تواق للعودة إلى سوريا حتى لو كان مصيره هو الاعتقال، لكن جسمه لم يعد يحتمل التعذيب في السجون.
كان ميشيل كيلو، رحمه الله، يتقصد أحياناً التركيز على التفاؤل. هذا كان مقصوداً لأنه يريد الإبقاء على الأمل. كان جريئاً، وكان إخلاصه لسوريا مميّزاً. ضحّى لأجلها ولم ينكسر. يحزّ في نفسي أنه لم يرَ سوريا التي ناضل لأجلها، لكن وصيته الاخيرة دعوة للاستمرار في العمل المشترك لتحقيق أهدافه، وهذا أفضل عزاء له.
رجل أعمال سوري-بريطاني
موقع الجمهورية
—————————
ميشيل كيلو.. الصوت الذي لن يغيب/ يحيى العريضي
ما يلي ليس إشادة بميشيل كيلو أو تبجيلًا له، مع أن الرجل يستحق ذلك ويليق به كواحد من أهم طلاّب الحرية عالميًا. فعْلُه، وما جرى له، ورواه، وأفكاره العلنية، لا تحتاج إلى شهود؛ فهو ببساطة سورية التي يريدها ويطمح إليها كل سوري حقيقي. سأسلط الضوء فقط على منتجٍ قدّمه هذا الرجل، يجعلنا نعرف أين نقف، وما حدث لنا، ولماذا..
جدير بالذكر أن كتابة ميشيل كيلو ومفرداته وجمله ومعانيه يصعب تكثيفها أو تلخيصها؛ لأنها ذاتها عصارة دلالية نابعة من راصد عاقل، وباحث مجرّب، وميداني خبير. وللحقيقة، اجتهدتُ يومًا وتحدثتُ في إحدى دراساتي عن بنية دولة الأسد التي جعل أيديولوجيتها مبنية على مبدأ المواجهة لا التعايش بين الحاكم والمحكوم؛ وإذ بي أكتشف، بعد التعمق بما كتبه ميشيل كيلو، أنني أسبح بشبر ماء مقارنة بعمق ما قدّمه. فهو يرى أن المواجهة بيد الحاكم هي التركيبة المجتمعية المريضة المنخورة التي صنعها الأسد بفعل “دولته العميقة” المتمثلة بأجهزة الموت التي خلقها، حزبيًا ومخابراتيًا وطائفيًا واقتصاديًا، لتكون طوع بنانه، وتلغي بدورها الإنسان السوري الحقيقي.
في ثلاثة كتب قاربت صفحاتها الألف، قدم ميشيل كيلو سورية بعد استقلالها الأول. جلّ تركيزها كان على ما فعله “الفرد” الأسد بسورية؛ وأقام “الدولة الأسدية” التي عبثت بسورية الوطن، فألغت الإنسان والوطن. تقع هذه المجلدات في ثلاثة أجزاء تحت عنوان: (من الأمة إلى الطائفة – سورية في حكم البعث): الأول من عام 1947 حتى 1966، والثاني من عام 1966 حتى 1970، والثالث من عام 1970 حتى قيام ثورة سورية 2011.
في الأول، يتحدث كيلو عن تأسيس “البعث” بأهدافه، وشعاراته، وطموحاته، وتحولاته، وسقطاته، وخيباته، والواقع الذي اصطدم به عربيًا ودوليًا؛ ورؤيته تجاه الأمة، والوحدة، ثم الانفصال، واللجنة العسكرية، وصولًا إلى 23 شباط 1966؛ وامتطاء البعث الحقيقي من قبل حزب السلطة: “الأسدية”.
يبدأ الجزء الثاني بالتطورات، والصراعات، والأفخاخ التي سبقت حرب سبعة وستين، داخليًا وعربيًا ودوليًا، مرورًا بالوحدة، والانفصال و”ثورة” آذار، وكارثة 1967، وخسارة أرض الجولان السورية؛ وجعل نتائج الاحتلال أداةً لإعادة هيكلية المنطقة، وكيف أصبحت إسرائيل أداة وذريعة في تلك الصراعات والمآسي والتلاعب بمصير المنطقة وشعوبها؛ حيث يرى ميشيل كيلو أن كارثة حزيران 1967 كسرت، بصورة نهائية، ما كان يعتبر طوقًا عربيًا مضروبًا حول إسرائيل، وجعلت شعار “تحرير فلسطين” الشماعة التي يعلق عليها الاستبداد كل ما يريد، ووأدت “حركة التحرر والنهوض العربي”. ومع حركة الأسد “التصحيحية”، تم إخراج السياسة من المجتمع، والمجتمع من السياسة؛ ونشأ شرخ لا يُرمّم، بين الحاكم والمحكوم الذي لم يرَ فيه النظام الحاكم إلا عدوًا. فحركة الأسد أحلت الاستبداد محل الديمقراطية، والقسر بديلًا للحرية، والتجزئة مكان طموح الوحدة؛ وفتحت مع الخارج ارتهانًا لتحمي أبديتها. عام سبعة وستين، كان حافظ الأسد قد غيّب الحزب والحكومة، وكان ذلك أول توثيق علني بأنه أضحى الحاكم بأمره في سورية، حيث اعتَبَر الحزب ستارة أيديولوجية محدودة القيمة، من خلال تحويله إلى مجرد متعاون أو ممسحة للدولة العميقة كجسد مترهل دون عمل.
يرى كيلو أن المؤسسة العسكرية ودولتها العميقة سيطرت على الحياة السورية والمجتمع عمومًا، حيث قام الأسد ببناء حزب سياسي آخر غير حزب البعث، واسمه الفعلي “حزب الأمن والجيش”، وحمّله اسم “البعث” لصاحبته “الدولة الأسدية العميقة”.
يكرّس ميشيل كيلو الجزء الثالث لعصر الأسد وما فعله بسورية. وبحسب كيلو، كوّن الأسد تركيبته تلك عبر آلية “الاحتواء”، من خلال شفط وتمزيق وتشتيت إنتاجية المجتمع المادية والبشرية؛ ونشر فيه الفساد والإفساد؛ وغذّى ونمّى كل تخلف وتحجر فيه؛ بحيث لا تقوم له قائمة من خلال وضعه أمام الخيار الوحيد: الولاء المطلق للأسد، أو الزوال. فأي محاولة لمغادرة مجتمع الحرمان والعبودية والتمزق وتأليه الأسدية، جريمة وخيانة وطنية!
أوجد الأسد منظمات ونقابات واتحادات مهنية منفصمة ومنفصلة عن بعضها البعض وعن منتسبيها، بالرغم من ادعائها تمثيلهم، ولكن قياداتها أدوات تدجين بيد عناصر الدولة القمعية العميقة غير المعروفة إلا بفعل الخوف والرعب والوهم المتاصل في الذهن، والحاضرة في عملية السطو والتمزيق، حيث كانت المهمة الأساس لتلك العناصر الاقناع أن العبودية هي المصير الأفضل، وإلا…
يرى ميشيل كيلو أن الأسد أوجد دستورًا يحمل في طياته بذور وأدوات القمع اللازمة، تحت اسم قوانين، كي يكون “مجتمع الاستبداد” مقوننًا، وكي يلمس “مجتمع الحرمان” أو “المحرومين” ملامح قوننة، ولكنها قوننة استبداده؛ حيث كان تناقض القوانين وإمكانية الالتفاف عليها ضرورات لإفشاء الإفساد والفوضى اللازمة؛ أما القانون الحقيقي فلا وجود له. المتوفر فعلًا هو قانون الرعب والاستبداد وتقرير المصير عنوة. لقد كان “الارتباط بالأجهزة” في الدولة العميقة، ولو بأدنى المراتب الوظيفية، هو سيد المكان.
في دولة الأسد، الولاء للسلطة؛ وليس أي سلطة، بل لدولة الأسد العميقة، التي تحدد نسبة الوطنية. ومن هنا تجد أن “مجتمع المحرومين” مغيَّب معطَّل مستبعَد ممزق، لا حول له ولا قوة؛ يقبل الحكم الجائر وخسارة حقه، خشية من الانتقام، حيث بدا وكأنه مجتمع “لا يحق أن يكون له وطن”. من “مجتمع المحرومين” هذا، تمَّ شفط النخبة إلى المنفى أو إلى القبر أو إلى المعتقل أو إلى صفوف مجتمع السلطة، لتكون بدورها أداة تسلط وفساد وإفساد. “مجتمع المحرومين” هذا هو الذي تم تدميره في سورية.
عندما يفرغ أي إنسان عاقل، أو بربع عقل، يفكّر ويشعر بأن ألف ثورة يجب أن تقوم في سورية. ثورة يستحيل أن تموت برؤية ميشيل كيلو، ولكل هذا كَتَبَ وصرخ ميشيل كيلو، ولكل هذا تعرَّض لكل ما تعرض إليه، ولكل هذا ما رسمه لا بد أن يكون ضوء منارة وخط هداية ومنهج عمل، لاستعادة سورية التي تليق بأهلها ويستحقونها.
مهما كُتب عن ميشيل كيلو وعن إنتاجه الفكري الثوري التحرري الإنساني في مقالاته ومقابلاته وأحاديثه ومواقفه، فلن يفيه حقه. إنه الإنسان الثائر المثقف النبيل. إنه الصوت السوري الحر الذي لن يغيب.
مركز حرمون
————————–
====================
تحديث 29 نيسان 2021
———————-
الموت ليس فرصة لتصفية الحساب: عن ميشيل كيلو والآخرين/ فايز سارة
وسط ما بدا من إجماع سوري على تقدير قيمة الراحل ميشال كيلو ودوره، والعزاء به والترحم عليه، انطلقت أصوات خافتة، بدت منفردة، ثم أخذت تتصاعد وتتجمع، لتخرق شبه الإجماع السوري…
توفي ميشيل كيلو الكاتب والصحافي السوري، وأحد أبرز رموز المعارضة السورية. إذ يمتد حضوره ونشاطه فيها إلى أكثر من 50 عاماً، كان في خلالها حاضراً في التفكير والكتابة وفي القول والنقاش، وفي التواصل وإقامة العلاقات مع الأشخاص والتنظيمات السياسية والاجتماعية، وإطلاق المبادرات في كل اتجاه ومستوى، إضافة إلى الانخراط في تنظيمات سياسية واجتماعية وغيرها.
واصل كيلو بعض تلك الأنشطة حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إذ أطلق وصيته للسوريين للخروج ظافرين من المعركة ضد نظام الأسد، وتمنى في لقاء مصور معه، أن يساعد السوريون بعضهم بعضاً في مواجه جائحة الجوع، ولم يقصر إلا بداعي عدم القدرة على الرد على الرسائل والاتصالات التي كانت ترد إلى هاتفه النقال.
ولأن ميشيل كيلو كان على هذا النحو من القدرات والنشاط والعمل والعلاقات، بدا من الطبيعي، أن يقابل موته بقدر كبير وغير مسبوق من اهتمام السوريين ومشاركتهم عائلته وأصدقاءه العزاء، بل في عزاء بعضهم بعضاً، وقد صاروا عائلة واحدة وأهلاً للراحل الذي لم يكن يراهم في يوم من الأيام إلا على هذا النحو، باستثناء قلة من بطانة نظام القتل والاستبداد والمرتبطين به، وقد باعوا ضمائرهم، وجعلوا حواسهم خارج متابعة ما حصل في سوريا في العشر سنوات الماضية، وهي امتداد فج لعشر قبلها من عهد الابن وثلاثين أخرى أمضاها السوريون في ظل الأسد الأب ذاقوا فيها الأمرين.
وسط ما بدا من إجماع سوري على تقدير قيمة الراحل ميشال كيلو ودوره، والعزاء به والترحم عليه، انطلقت أصوات خافتة، بدت منفردة، ثم أخذت تتصاعد وتتجمع، لتخرق شبه الإجماع السوري، وتندرج في ثلاثة مسارات أولها “سياسي”، والثاني “قومي” والثالث “ديني”، سجلت اعتراضاتها على الموقف السوري العام ازاء رحيل كيلو، وسعت إلى نبش ما أمكن من نصوص ومواقف وممارسات، وأحداث، لدعم موقفها.
المسار الأول للاعتراضات الذي اتخذ الطابع السياسي، تبدى بموقف أصحابه في اختلافهم مع ما كان لميشيل كيلو من مواقف وآراء، تختلف مع آرائهم ومواقفهم في القضية السورية أو تُناقضها. وهم بهذا لا يناقضون الطبيعة البشرية بما فيها من اختلاف بين شخص وآخر فقط، بل يرغبون في أن يكون الرجل متطابقاً مع مواقفهم وآرائهم، وإن كان غير ذلك، فلا بد من التشكيك به وبما أحيط برحيله من اهتمام واسع.
ويقارب المسار الثاني مثيله الأول في محتواه، وإن كان مختلفاً في واجهته، وأكثر تعقيداً من سابقه، وقد تكرس في اعتراضات سوريين أكراد على بعض مواقف كيلو وأقواله، التي ظهرت إزاء تطورات الحدث السوري في السنوات الماضية. وإذا كان من الحق، أن أشير إلى آراء ومواقف، قطعت من سياقها العام لغاية في نفس يعقوب، وهذا امر دارج في السياسة السورية، فيمكن القول، ان الرجل وكل العاملين في المجال السياسي، يمكن أن يتخذوا موقفاً، أو يعلنوا رأياً لا يتوافق مع آخرين، أو يتعارض مع سياق مواقفهم العامة. والحكم على الآراء والمواقف، ينبغي ألا يكون معزولاً عن إرث صاحب الموقف والرأي وتاريخه، إلا إذا كان يمثل تحولاً جوهرياً في مسار الشخص في القضية المحددة. وإذا كان الكلام حول موقف ميشيل كيلو من القضية الكردية، فإن الموضوع لا يحتاج نقاشاً طويلاً، فقد كان الرجل من أكثر السوريين تأييداً لحقوق الأكراد وضد ما تعرضوا له من انتهاكات وسياسات عنصرية، وبخاصة التي مارسها نظام البعث، بل إن علاقات ميشيل مع الأكراد ونخبتهم السياسية والثقافية أمر معروف… وكانت عنصراً فعالاً في تجسير علاقات الأطراف السياسية العربية والكردية والانفتاح بينهم في فترة ربيع دمشق، والتي كان للجان إحياء المجتمع المدني دور كبير فيها، وكان كيلو أحد أركانها. وتقديري أن الانتقادات التي ظهرت على هامش رحيل كيلو جاءت من شباب أكراد إما لا يعرفون الرجل حق المعرفة، أو هم من شبان حصلوا على جرعة زائدة مثل تلك التي حصل عليها أمثالهم من الشبان العرب في غمرة المناكفات العربية- الكردية، التي لا تنفع أحداً، وتضر بالطرفين. وفي الحالتين علينا ألا نأخذ معظم ما قيل على محمل الجد.
المسار الثالث في الاعتراضات طابعه “ديني” ويتصل بالمتدينين وجماعات الإسلام السياسي في تعاملهم مع رحيل ميشيل كيلو ولا سيما لجهة النعي والترحم. فقد نعت جماعات الراحل، وقدرت نضاله الطويل والمتواصل ضد نظامي الأسد أباً وابناً، لكنها تجنبت الترحم عليه على نحو ما تضمن نعي صدر عن المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين محمد وليد، التزاماً بما يعتقده المتدينون من عدم جواز الترحم على غير المسلمين، بل وأحياناً على المسلمين الذين ينزعون عنهم صفتهم الاسلامية. تماماً كما فعل عماد الدين رشيد الذي يتزعم جماعة إسلامية صغيرة عند وفاة المفكر السوري الطيب تيزيني، فأكد عدم جواز الترحم عليه. والغريب أن شخصاً مشهوداً له بالاعتدال من بين الشخصيات الإسلامية السورية، هو عصام العطار الذي كان صديقاً للراحل كيلو، نعاه، من دون أن يذهب حد الترحم عليه، ما يؤكد توافق الإسلاميين في جماعاتهم وشخصياتهم على عدم الترحم، في سلوك يكرس موقفاً متشدداً تمييزياً يقوم على أساس الانتماء الديني في التعامل مع موت شخصيات ذات أهمية وطنية.
قبل أن أختم أود أن أشير في غمرة ردودالفعل إزاء وفاة الراحل ميشيل كيلو إلى نموذجين ظهرا مميزين في نعوته وسط شبه الإجماع السوري على تقدير كفاحه ودوره ضد نظام الأسد، أولهما قناة “أورينت”، والثانية قناة “سوريا”، إذ قامت كل منها بتغطية واسعة لرحيله، واستضافتا كتاباً وصحافيين وسياسيين للتعليق على الحدث. ثم انفردت الأولى بفتح ملف تشهير ضمني بمواقف الرجل وآرائه، وهذا مفهوم في ضوء الخلافات بين الراحل وصاحب المحطة، ما جعل نقاش مواقف كيلو وآرائه، فرصة لتصفية حسابات قديمة. أما تغطية تلفزيون “سوريا”، فقد بدت وكأنها مزايدة على السوريين باعتبار أن كيلو أحد أركان تلك المحطة ومشغليها في وقت لا يتجاوز عمرها وصلاتها بالقضية السورية سوى سنوات قليلة، بينما نضال كيلو والسوريين ضد نظام الأسد يعود إلى عقود.
درج
————————–
بعض من ميشيل كيلو الباقي معنا/ نجاتي طيارة
أزعم أن قلّة من السوريين قبل السبعينيات كانوا يسمعون باسم ميشيل كيلو المترجم الكبير لكتب مهمة عن الديمقراطية الأوروبية والأمبريالية والماركسية، وموضوعات أخرى في الاقتصاد السياسي، وتلك القلة كانت -بطبيعة الحال- محصورة بنخبة المثقفين والقرّاء الذين كانوا على صلة بعالم الكتب، بخاصة منها الصادرة عن وزارة الثقافة السورية التي كان يعمل فيها الراحل الكبير، والمجلات الثقافية السورية كالمعرفة والآداب الأجنبية اللتين كان يشارك في تحريرهما في ذلك الزمن. علمًا أن عدد النسخ المطبوعة من أيّ كتاب، حينذاك، لم تكن تتجاوز بضعة آلاف، أما نسب انتشار المطالعة بين السوريين، فكانت توازيها بؤسًا، مع انحدار التعليم وانتشار ثقافة الشعارات والحزب القائد.
كما كانت قلة أخرى، من نخب اليسار المعارض، مطلعة على مشاركته في كتابة أبرز الافتتاحيات والمقالات السياسية في صحف المعارضة السريّة، طوال فترة الصمت التي غرقت فيها سورية قبل موت الدكتاتور الأب، إلى جانب صحف المقاومة الفلسطينة لفتح وغيرها.
لكن الجمهور الأوسع من السوريين، تفجّر تعرّفه إلى ميشيل كيلو، أواخر السبعينيات، مع الأزمة التي عصفت بسورية على إثر جريمة مجزرة المدفعية صيف عام 1979، التي جعل منها النظام ذريعة جديدة لاستكمال إغلاق المجال السياسي وتقييد الحريات العامة، وقوننة ذلك تشريعيًا، فما كان من الراحل وثلّة من المثقفين الأحرار، برز بينهم الشاعر الراحل ممدوح عدوان، إلا أن واجهوا ذلك بقوة وشجاعة، بالنقد الصريح والعلني والحريص على المصلحة الوطنية العامة، وذلك في اللقاء الشهير الذي عقده ممثلو سلطة الأسد معهم، بقصد تطوير عمل الجبهة الوطنية التقدمية، في محاولة لامتصاص الاحتجاج واحتواء المثقفين. فانقلب الأمر عليهم، إذ فضح ميشيل طبيعة الجبهة التي كان نظام تأسيسها قد منع نشاط الأحزاب بين قطاعات الجماهير، بينما لم تكن تلك الأحزاب أكثر من تجمعات ضعيفة حول شخصيات بارزة، فصارت مجرد ملحقات للتأييد والتصفيق، وتابع ميشيل نقده بطرح برنامج كامل للإصلاح، أظنه بقي مناسبًا حتى فترة متأخرة! فانتشر عقب الاجتماع “كاسيت” مسجل للحوار الذي دار، تحولت نسخه إلى ما يشبه الرسالة الصوتية المعممة كفيديو بلغة اليوم. تبع ذلك لاحقًا حراك مدني واسع، افتتحه بيان النقابات المهنية وشاركته البقية الباقية من أجساد الأحزاب المعارضة المهشمة تحت ضربات القمع والسجن والتهجير القسري، لكن الأمر انتهى بحل تلك النقابات واستفحال القمع، وإغلاق كل مجال عام، خصوصًا بعد ارتكاب النظام مجزرة حماة الكبرى.
منذ تاريخ ذلك الكاسيت، دخل ميشيل السجن السياسي، وسيتكرر ذلك، لكنه صار عنوانًا جماهيريًا لدور المثقف السوري الحر، وتكرّس دوره المنخرط في نشاطات لا تكلّ ولا تملّ، من أجل استعادة الحريات العامة في التعبير والعمل والتنظيم وغيرها، وفتح الأبواب أمام مختلف فعاليات المجتمع السوري السياسية والمدنية للمشاركة في أمور الشأن العام ومعالجته ونقده بحرية، كما صارت شديدة الشيوع جملة الشاعر ممدوح عدوان: “إنهم يكذبون حتى في النشرة الجوية”.
وفي كلّ ذلك، كان ميشيل دينامو مبادرات ومشاريع، أعطت دورًا جديدًا للمثقف السوري، ظهر في دعواته المتتالية لإطلاق البيانات العلنية، بتوقيع أصحابها المثقفين والناشطين من كل أرجاء سورية، وذلك تجاوزًا لإنغلاق آفاق العمل السياسي المباشر، وتحول أحزاب المعارضة السياسية المهشمة إلى العمل السري، تحت ضغط إرهاب السلطة وقمعها. فكانت تلك البيانات خرقًا للصمت السوري المكرّس، وإعلانًا عن قيمة الذات الفردية الحرة ودورها في المبادرة وتحمّل المسؤولية الوطنية، إلى جانب الدفاع عن قيم الحرية عمومًا. وقد تجلى ذلك في كلّ مناسبة وحدث عام محلي أو متعلق بالمحيط العربي لسورية، وبخاصة ما يتعلق منها بفلسطين ولبنان، حيث كان يؤكد دومًا على ارتباط النضال ضد الاستبداد فيهما بالنضال السوري الداخلي، حتى صحّ القول بأنه كان حزبًا أو تيارًا وحده، من شدة غزارة مبادراته وانفتاحها على مشاركة العديد من المثقفين والناشطين معه، ولعل ذلك كان البذور الأولى لمبادراته المرتبطة بفكرة المجتمع المدني لاحقًا، التي عبّرت عن مغادرته أوهام الأيديولوجيا الاشتراكية، مع استمرار نزوعه اليساري المؤمن بالعدالة والمنفتح على قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.
أما تلك المبادرات، فقد امتدت إلى ميدان الشارع الجماهيري لاحقًا، مع ولادة لجان المجتمع المدني مفتتحة ربيع دمشق مع بياناتها وبيان الـ 99. فكانت الدعوة إلى اعتصام الأحد، الذي كثيرًا ما تحوًل إلى تظاهرات كبيرة، انضم إليها المثقفون والناشطون من كل أنحاء سورية، وكانت تنطلق أمام مقرّ الأمم المتحدة في شارع أبو رمانة وسط دمشق، للتعبير عن التضامن مع قضايا التحرر العربي، إلى جانب مطالبات عامة حول الحرية والمواطنة. ومثلها كانت الدعوة إلى خميس فلسطين تضامنًا مع الانتفاضة. فشكّل ذلك تدريبًا أوليًا على التظاهر، الأمر الذي كثيرًا ما أربك السلطة وأجهزتها الأمنية. كما ظهرت منتديات الحوار، وانتشرت كما ينتشر الفطر في كل أنحاء سورية، منتزعة حق الاجتماع والتعبير والتنظيم الذي طالما حجبه النظام الأسدي، لكن لفترة.
تلك المبادرات والحيوية التي لا تنضب الكامنة خلفها، هي ما ميزّت الراحل دومًا، وفي كل ذلك، أزعم أنه لم يكن مدعوًا، بل كان داعية، في الأعم والأغلب!
لكن المقال السياسي كان مجاله الآخر، الذي جعل اسمه مدويًا، محليًا وعربيًا، إذ بدأ الكتابة النقدية ضد الاستبداد السوري، لاحقًا لخروجه الأول من السجن، وفي الصحف العربية التي منع بعضها من الدخول إلى سورية، أو قنن دخولها بشكل مقصود، كما حدث مع (السفير) صديقة النظام السوري. وفي ذلك، تابع بجرأة ورصانة تحليله لتغوّل السلطة السورية وفسادها، معريًا تمويهها الأيديولوجي بأقنعة الاشتراكية والقومية، التي كثيرًا ما وظِفت لخداع الجماهير وتيارات اليسار العربي.
وصارت مقالاته الغزيرة تنقل وتنسخ وتعمم، ليس بسبب مضامينها النقدية الصريحة التي تتابع مشكلات الهمّ السوري المزمنة أولًا، بل بسبب عناوينها المبتكرة ولغتها وبيانها الجميل والمقروء من عامة الناس أيضًا، مثل: مراحل تفكك النظام الشمولي، إصلاح الرأس رأس كلّ إصلاح، فالج لا تعالج.. والتي لم تسقط يومًا في سفسطات بعض المثقفين وغموضهم. وإذ لا يتسع المجال للحديث عنها، فذلك قد يتطلب كتابًا بحاله، لذلك سأتوقف عند واحدة من أبرزها في مرحلة الوريث، وهي مقالة (نعوات سورية: القدس العربي 12/5/2006) التي لم تتجاوز الألف كلمة، لكنها تستحق أن تتوج كواحدة من أشهر مقالات الأدب السياسي العربي قاطبة. ففي تلك المقالة التقط، بعين عالم الاجتماع السياسي الخبير، المفارقةَ بين نعوات أبناء مدينة اللاذقية وأبناء ريفها، وهي مفارقة كشفت الوضع الاجتماعي والطبقي البائس الذي انحدر إليه أبناء الفريق الأول، فظهروا غالبًا كأصحاب حرف أو أعمال حرة أو موظفين متوسطين وصغار، كما كشفت واقع أبناء الريف الذين يعيش معظمهم على ريع السلطة، وبخاصة العسكري والأمني منه. فكان لهذه المقالة أثرٌ مدوّ كفضيحة كاشفة في سورية، ومحيطها العربي. وهو ما أثار حفيظة المركب السلطوي الأسدي بشدة، وكان خلف التوتر الأمني الذي أحاط بالراحل يومها، ثم تجلى بالحقد الذي ظهر في تعذيبه الشاق والمتنوع، عند اعتقاله السياسي مجددًا، على الرغم من عمره الذي بلغ السادسة والستين حينها، ومكانته كواحد من أبرز المثقفين الديمقراطيين السوريين المعروفين، عربيًا وعالميًا. وهو الاعتقال الذي استمر حوالي ثلاث سنوات، لاتهامه بمسؤوليته عن إعلان بيروت – دمشق، الذي وقعه مع عدد من المثقفين والناشطين السوريين واللبنانيين، وكان مثالًا آخر عن ترابط النضال ضد الاستبداد في سورية ولبنان والمحيط العربي.
ولم تتوقف مبادراته بعد خروجه من السجن الثاني، فقد تابع نشاطه وتقدّم بمبادرة سياسية نوعية، تمثلت بالدعوة إلى تعاقد وطني جديد حمل اسم إعلان دمشق، لإنهاء الشقاق الوطني مع التيار الإسلامي على أسس ديمقراطية، فصاغ مسودتها الأولى مع صديق عمره الراحل حسين العودات، بعد لقاء مع مرشد الإخوان المسلمين السوريين صدر الدين البيانوني، في مراكش، على هامش أحد المؤتمرات. ومرة أخرى، كرر النظام طبيعته الأصلية، رافضًا كل دعوة للحوار، ولاجئًا إلى القمع والاستبداد على عادته، فلجأ إلى اعتقال قادة الإعلان بعد ظهوره كمؤسسة ونشاط لافت، كما انتهى إلى وأد ربيع دمشق أيضًا.
وما إن تفجرت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن، حتى التحق بها شباب سورية، وخرجت تظاهراتهم في أنحاء مختلفة من البلاد، لتصطدم بالقمع والتعسف غير المسبوق. فسارع الراحل إلى تأييد حراكهم، مطالبًا بتحقيق مطالبهم السلمية في مرحلتها الأولى، ومتوجهًا بإلحاح إلى السلطة في مقالاته وإطلالاته العديدة، للمسارعة إلى الحوار والإصلاح، نظرًا لإدراكه العميق لتصلّب مُركّب السلطة، وحذرها من فتح باب التغيير، وكان شعاره في ذلك: قول صديقه وأستاذه الكبير الراحل إلياس مرقص: “رُبّ إصلاح أكبر من ثورة”. ولم يأل جهدًا في محاولة فتح جسور الحوار، ولم يأنف من بذل أي محاولة في ذلك، فتوجه للحوار مع رؤساء فروع الأمن الذين أدرك دومًا بأنهم أصحاب السلطة الحقيقية، كما قصد القصر الجمهوري متمنيًا عدم اللجوء إلى الحل الأمني، ومنع الاحتراب الوطني، لكن بدون فائدة، كما كشف عن ذلك المحللّ رامي الشاعر في مقالته عنه، علمًا أن هذه المرونة السياسية، الحريصة على منع الكارثة الوطنية، دفعت ذوي الرؤوس الحامية في معسكر المعارضة إلى التعريض به.
وقد بقي الراحل طويلًا ضدّ العسكرة، فساهم في نشاط هيئة التنسيق الوطنية وشعاراتها الرافضة للعنف والطائفية والتدخل الأجنبي، لكن تصلّب النظام الأسدي ولجوءه مع حلفائه الدوليين إلى العنف الإجرامي اللامحدود، ورفضه لأي حوار، وصولًا إلى التدمير الكارثي وسياسة التهجير، مطبقًا برنامج الإبادة الجماعية تحت اسم (سورية المفيدة)، كلّ ذلك دفع الراحل أخيرًا إلى الخروج من سورية. لكنّه لم يتوقف عن محاولة بناء مشاريع تكوينات ديمقراطية، من المنبر الديمقراطي، إلى الاتحاد الديمقراطي، إلى الكتلة الديمقراطية، عند مشاركته في مؤسسة المعارضة السورية الرسمية (الائتلاف الوطني) التي لم يلبث أن غادرها بعد سنوات، حينما أيقن عبث التخلّص من تبعيتها وسيطرة عصبوية عليها. مع ذلك بقي حريصًا على انتمائه للثورة. وعلى الرغم من كل تراجعاتها وما لحق بها من عطب وكوارث، فقد أبى إلا أن يتابع الحوار من داخلها. وسواء أخطأ هنا أم أصاب هناك، في ممارسته فنّ الممكن السياسي، فقد كان في السنوات الأخيرة يستجيب بنشاط فائق ومدهش لندوات ناشطيها ومجموعاتها وأسئلتهم، متابعًا تلبية فيديوهاتها وصوتياتها، على الرغم من تقدمه بالعمر ومعاناته الصحية، فتراكم في هذا السياق مخزون كبير، سيشكل إلى جانب مقالاته، وكتبه بخاصة منها الأخير (من الأمة إلى الطائفة) وروايتيه، ذخيرة ومرجعية معرفية كبرى للأجيال القادمة، التي آمن دومًا بمستقبل قيادتها لسورية الديمقراطية.
هذا بعضٌ من ميشيل الذي لا يمكن أن يغيب عن ذاكرة السوريين الأحرار، والذي وصفه د برهان غليون، صديق عمره بحق، بأنه كان شخصية ساحرة، وقوة من قوى الطبيعة الفذة. وهو نفسه الذي كان صديقًا حميمًا للكثيرين، ويطلب سماع آرائهم، على الرغم من تواضع أدوارهم وثقافتهم بالقياس إليه، وأنا شخصيًا واحد منهم.
رحم الله فقيدنا الكبير، وأعاننا على الاستجابة لوصيته وندائه.
مركز حرمون
————————–
ميشيل كيلو وطنية صادقة ووفاء سوري أصيل/ عبد الباسط سيدا
كُتب الكثير حول الصديق العزيز الأستاذ ميشيل كيلو، بمناسبة رحيله الأبدي، ومغادرته لدنيانا بتبايناتها وتعقيداتها، خاصة في منطقتنا وعلى وجه التحديد في سورية التي ما زالت تعيش الأحزان والآلام نتيجة الحرب الظالمة التي أعلنها نظام بشار على الشعب، بدعم ومساندة مستمرين من جانب رعاته، خاصة الإيراني الذي أدخل حشدًا غير مسبوق من الميليشيات المذهبية إلى سورية لتدمير عمرانها، وتهجير سكانها، وخلخلة تركيبة بنيتها السكانية، وحماية “النظام العلماني الحامي للأقليات” الذي بات أداة أساسية في المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة كلها.
وسيُكتب الكثير عن أبي أيهم في المستقبل؛ فمسيرته السياسية طويلة، ونتاجه الثقافي غزير، ولديه عدد هائل من المقابلات والتحليلات والتصريحات، ولديه تجارب تنظيمية عديدة؛ وكل ذلك سيكون في الأيام والسنوات المقبلة موضوعًا للاطلاع والتحليل والبحث والنقد والتقويم من جانب المعنيين، لا سيما من قبل الباحثين المهتمين بمختلف جوانب شخصية ميشيل. فهؤلاء سيتناولون إرثه ودوره وتأثيره بأدوات معرفية موضوعية، تبرز بحيادية بحثية ما يُسجّل للرجل، وما يسجّل عليه. وكل ذلك سيكون في سياق تكريم وتقدير هذا الرجل الكبير الذي جمع بحيوية متميّزة بين الثقافة والممارسة في العمل السياسي؛ وامتلك من المهارات السياسية التي مكّنته دائمًا من فتح قنوات الحوار في أصعب الظروف وأحلكها.
كان يراهن في البدايات على إمكانية الإصلاح. ينتقد الأوضاع والإجراءات، ولا يقطع الأمل. يظل على التواصل مع من يتوسم فيهم الخير من مسؤولي الحزب الحاكم والدولة، لعله يؤثر فيهم بصورة إيجابية. ناقشهم بحكمة استمدت قوتها من وطنية صادقة، وحرص مسؤول على الوطن وأهله. انتقد قرارات نظام حافظ الأسد الخاصة بالإخوان وحزب العمل الشيوعي، وانتقد الفساد. ودعا باستمرار إلى احترام كرامة المواطن وحريته. اعتبر الحرية هي الأساس والمدخل لجميع الحقوق الأخرى. كان يمارس نشاطه علانية، ويعبّر عن أفكاره بكل وضوح وشفافية في الحوارات واللقاءات العامة، ومن خلال المقالات، وعبر اللقاءات مع المسؤولين من النظام، ومع المعارضين. يدعو إلى التفاهم على أساس تجاوز السلبيات، من أجل ضمان مستقبل أفضل للسوريين، وللأجيال السورية المقبلة على وجه التخصيص.
لقد اجتمعتْ في شخصية ميشيل كثير من الصفات الإبداعية التي نادرًا ما تجتمع في شخص واحد؛ فقد كان على أفضل العلاقات مع المفكرين والمثقفين السوريين والعرب، يحاورهم بندية وأريحية. كانت لديه علاقات واسعة مع السياسيين السوريين والعرب من مختلف الاتجاهات والانتماءات، فضلًا عن شبكة اتصالاته مع الأوساط الشعبية. وكان مؤمنًا بأهمية الحوار وجدواه مع الآخر المختلف، ويمتلك الأدوات التي تساعده باستمرار في كسر الجليد، وبناء العلاقات.
بذل جهودًا متميزة في إطلاق لجان إحياء المجتمع المدنيّ التي سرعان ما انتشرت فوق كل الجغرافيا السورية. وكان له دور أساسي في إصدار بيان 99 في أيلول/ سبتمبر 2000، ومن ثم البيان الألفي في كانون الثاني/ يناير 2001. وهو الذي استطاع إقناع الإخوان المسلمين بالانضمام إلى مشروع إعلان دمشق في بداياته عام 2005. كما تمكّن من إقناع القوى التي كانت قد توافقت على الإعلان المذكور بالقبول بفكرة العمل المشترك مع الإخوان، وذلك بعد أن كان نظام حافظ الأسد قد شيطنهم، وأصدر ضدهم القانون 49 عام 1980، الذي يقضي بالحكم بالإعدام على كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان. وهو قانون العار الذي كانت قد وافقت عليه أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، خاصة الحزب الشيوعي الذي كان يبرر وقوفه مع النظام من خلال الزعم بأنه نظام تقدمي، على علاقة جيدة مع الاتحاد السوفيتي، وهو الحزب نفسه الذي يصدر اليوم بيانًا يؤيد فيه إعادة انتخاب بشار الأسد رئيسًا، باعتباره ممثل حليفه (حزب البعث)، وحليف روسيا البوتينية التي يبدو أن أنظمتها الاستخباراتية ما زالت تتحكم في الحزب الشيوعي السوري، وغيره من الأحزاب اليسارية العربية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق.
ومنذ بداية الثورة السورية، أعلن ابو أيهم وقوفه إلى جانب الثورة السورية، على الرغم من ملاحظاته حول بعض الأطروحات والممارسات. ونظّم بالتعاون مع بعض السوريين لقاء المنبر الديمقراطي، في شباط/ فبراير 2012، ثم أسهم بصورة أساسية في تأسيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، في أيلول/ سبتمبر 2013؛ ودخل في تحالفات مع الأحزاب والتيارات الإسلامية في مرحلة الائتلاف. وكان باستمرار يمثل حلقة الوصل بين الجميع من هيئة التنسيق، إلى إعلان دمشق، والأحزاب الكردية، فضلًا عن الشخصيات المعارضة المستقلة.
كان يكتب باستمرار، ويظهر في الإعلام باستمرار، ويتواصل مع السوريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يدافع عن الثورة السورية، ويطالب بضرورة احترام تطلعات الشعب السوري نحو الحرية. وكان يحرص دائمًا على أهمية وضرورة اعتماد النظام الديمقراطي، وذلك لإتاحة المجال أمام جميع السوريين للتعبير عن آرائهم، والمشاركة في تحديد مصير شعبهم وبلدهم.
بعد عودته من موسكو صيف عام 2012، التي كان قد زارها على رأس وفد التقى بوزير الخارجية الروسي لافروف، اتصلتُ به من أجل معرفة ما توصلوا إليه مع الروس، والموضوعات التي تمحورت حولها النقاشات، وتنسيق الجهود من أجل القضية السورية؛ وكان إيجابيًا إلى أبعد الحدود، وتوافقنا على لقاء قريب. وقد كنا في المجلس نعدّ لزيارة مماثلة بناء على دعوة روسية، وسافرنا إلى موسكو، والتقينا في ذلك الحين مع وزير الخارجية الروسي وعدد من المسؤولين الآخرين. وما توصلنا إليه هو أن الروس ليسوا في وارد التخلي عن الأسد، وقد عبّرنا عن موقفنا في ذلك الحين، في مؤتمر صحفي عقدناه في موسكو نفسها.
كانت لدينا لقاءات عديدة مع الأخ ميشيل فيما بعد، في أماكن عدة، ولكن اللقاء الأكثر حميمة وقربًا ودفئًا كان ذاك الذي تم بينا مع جمع من الأصدقاء السوريين في بيت ميشيل في باريس؛ حيث تم التأكيد على ضرورة وحدة السوريين، وتماسكهم واستقوائهم ببعضهم في مواجهة النظام. وما زلت أذكر بساطة اللقاء وعفويته، وأجواءه السورية الأثيرة. قدّمت لنا السيدة المحترمة أم أيهم وقتها خبزًا وزيتونًا إلى جانب الزيت والزعتر. ربّما كانت تدري أنها تقدّم لنا ما هو المفضل باستمرار، أما النكهة فقد ذكرتنا بالبلد الجميل الجريح، وشعبه الكريم الطيب المضياف غير المتعصب. ثم كان العمل المشترك في الائتلاف، والتواصل المستمر بيننا في مرحلة ما بعد الائتلاف.
والتزامًا بالواقعية والموضوعية، لا بد أن نبيّن هنا أن الرجل لم يكن ملاكًا، بل كانت له هفواته وأخطاؤه السياسية والتنظيمية، وقد تسبّب أكثر من مرة في إغضاب قطاعات واسعة من السوريين. ويُشار هنا، على سبيل المثال، إلى العاصفة التي كانت بعد ما ذكره عن حديثٍ تم بينه وبين الشيخ أسامة الرفاعي. وكذلك استخدم تعبيرات غير موفقة، في تحديد موقفه من الموضوع الكردي السوري، هذا على الرغم من إعلانه القبول بفكرة الفيدرالية.
وكانت لأبي أيهم أخطاؤه التنظيمية ضمن الائتلاف وخارجه. ولكن الذين عرفوه عن قرب كانوا يعرفون أن هذه الهفوات لم تكن تنم عن مواقف سلبية مسبقة من هذا المكون السوري أو ذاك، أو من المسلمين والدين الإسلامي بصورة عامة، وإنما كانت تدخل ضمن إطار التسرع غير المحمود، والثقة بالنفس التي كانت تستمد نسغها من الإرث الوطني. ولكن، مع ذلك، يسجل للرجل بأنه كان يمتلك مهارة التحرك سريعًا لتجاوز المواقف الإشكالية، وذلك بحكمة سياسية مكّنته دائمًا من تدوير الزوايا، وجبر الخواطر، وتجاوز التباينات الثانوية، بغية التركيز على الصراع الأساسي مع النظام المستبد الفاسد المفسد.
واستمرت العلاقة الإيجابية التفاهمية بيننا، سواء في بعدها الشخصي الإنساني، أم على مستوى اللقاءات الوطنية التي كانت تجمعنا مع الأصدقاء. ودائمًا كان الهمّ السوري هو المحور الذي تتمفصل حوله حواراتنا ومناقشاتنا، ومشاريعنا.
تواصلت معه أكثر من مرة، وهو في المشفى يواجه الجائحة السوداء، كان متفائلًا بأنه سيتمكن من تجاوز الأزمة الصحية. ولكنني حينما اطلعت على وصيته، أدركت أنه قد شعر بقرب الرحيل الحزين. فخاطب السوريين من موقع الأب الخائف على أبنائه وبناته، والحريص على مستقبلهم. وقدّم رسالته الوطنية، وغادر مرتاح الضمير.
ومن أكثر ما يلفت النظر، هذاالإجماع السوري غير المسبوق على شخصية وطنية، في مرحلة من أصعب المراحل وأقساها، وأكثر فرقة وتباعدًا بالنسبة إلى شعبنا السوري المغلوب على أمره. فهل هو الشعور باليتم وسط كل هذا الحطام المجتمعي والعمراني؟ أم أنها الفطرة السورية السليمة التي تدرك أن ما ينقذ السوريين هو حرصهم على القواسم المشتركة، وتجاوز التباينات العابرة، وتقدير أولئك الذين حافظوا على الجسور، وعملوا باستمرار على تجديد الأمل عبر التواصل والتفاعل الإيجابي مع الآخر المختلف من شركاء الوطن والمصير.
تعازينا للأسرة السورية الكبيرة، ولأسرة الفقيد الكبير ميشيل كيلو الذي أتخيله الآن سعيدًا مرتاحًا، معتزًا بكل هذا الوفاء السوري الأصيل.
مركز حرمون
———————————
====================