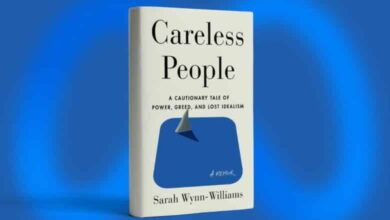عرض لكتاب ديرك موسز: مشكلات الجينوسايد/ ياسين الحاج صالح
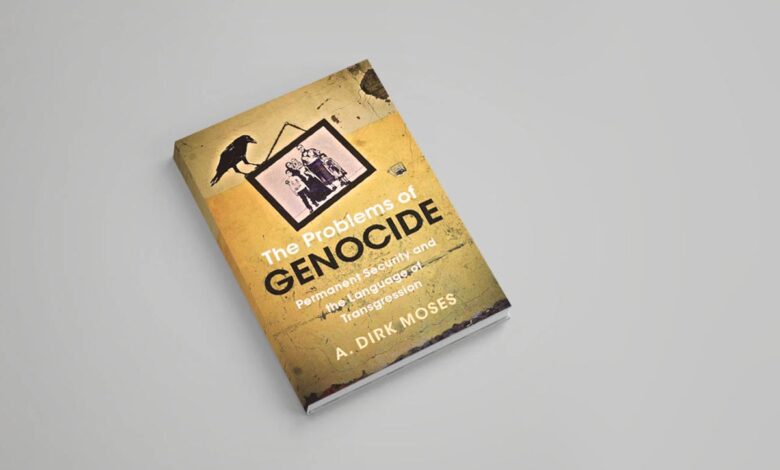
مشكلات الجينوسايد: الأمن الدائم ولغة الانتهاك هو عنوان كتاب آ. ديرك موسز، وقد صدر للتو عن منشورات جامعة كامبردج. الكتاب الذي يقع في نحو 600 صفحة، تحتوي آخر 90 صفحة منها فهرساً تحليلياً، عظيم الأهمية بغنى محتواه وبقوة أطروحته الرئيسية، وبتوثيقه الواسع، وبمنزع النقدي في تناول الهولوكوست، مما لا يصادفه المرء كثيراً في الكتابات الغربية عن الإبادة أو الجينوسايد. ويحوز الكتاب أهمية إضافية في سياقنا السوري والعربي بالنظر إلى ما تقتضيه تجاربنا الأحدث من وجوب تجديد اللغة السياسية لاستيعاب هذه التجارب. من شأن اشتباك نقدي مع أدبيات الإبادة أن يساعد في ذلك.
الأطروحة الأساسية لكتاب موسز هي أن مطلب الأمن الدائم، وليس نزاعات الكراهية، هو ما يكمن وراء الإبادات الكبرى، بما فيها الهولوكوست، التي يقول المؤلف إنه النموذج الأصلي لمفهوم الجينوسايد، بحيث يشخّص ما يجري من مجازر في بلد ما كجينوسايد بقدر ما هو يشابه الهولوكوست. ومعلوم أن هذا النموذج اكتسب قوة قانونية ورمزية منذ تبنت الأمم المتحدة المفهوم وعرفته بدلالة هويات المستهدَفين «القومية أو الأثنية أو الدينية أو العرقية»، أي أن جماعة بشرية تُستهدَف لكونها هي من هي، وليس لأي شيء فعلته أو فعله منسوبون إليها، ولا بمحصلة أوضاع وديناميات سياسية حربية متشابكة ويتعين تحليلها وفهمها. وبقدر ما يتضمن مفهوم الجينوسايد نظرية ضمنية تُغيِّب السياسة عموماً، والصفة السياسية للصراعات التي تمخضت عن إبادات، فإنه يجري إبراز الهويات كما لو أنها أشياء معطاة دوماً وسلفاً ومتماثلة عبر التاريخ. ولأن الجينوسايد جريمة كراهية، بحسب رافائيل ليمكين، المحامي البولوني-الأميركي اليهودي الذي وضع مفهوم الجينوسايد أثناء الحرب العالمية الثانية، ولأن المفهوم عام (generic) حتى أنه مكرس في القانون الدولي، فإن على كل إبادة لاحقة أن تثبت أنها جينوسايد محفَّز بالكراهية حتى تستحق هذا الاسم الموجِب لتدخل دولي. ومن أجل إثبات ذلك، لا يكفي تعريف الضحايا بهوية مميزة مسبقة، بل وأن يكونوا أبرياء تماماً، لم يحملوا السلاح ولم يقاوموا، وسيقوا إلى حتفهم كالخراف. فإن لم يكن الأمر كذلك، فإننا حيال حرب أهلية أو «قمع تمرد» أو إرهاب… وهو ما يُنَسْبِن الصراعات الأخيرة مهما بلغ عدد ضحاياها، ويُسهِّل سحب الاهتمام بها بوصفها صراعات «معقدة» مثلما سمعنا مؤخراً بخصوص فلسطين، ومثلما سمعنا طوال عقد بخصوص سوريا. ويقوم على ذلك تراتب في الجرائم يتكلم عليه موسز، يضع الجينوسايد في مرتبة «جريمة الجرائم» – وهذا تعبير ليمكين نفسه – المستحقة للعقاب الدولي، فيما يقلل من شأن غيرها. وهكذا تشغل الإبادة الإيزيدية على يد داعش موقعاً مستوجباً للتدخل بحسب القانون الدولي، لأنه يمكن تقريب هذه الإبادة من الهولوكست. ما جرى في سوريا على يد الحكم الأسدي لا يشبه الهولوكوست، إذن ليس جينوسايد، وبالتالي لا يقتضي القانون الدولي مساعدة السوريين. وفي هذا ما يمارِس ضغطاً على الناشطين والمناضلين السياسيين لإثبات أن ما يجري في بلدانهم هو جينوسايد، بل ولتأويل ما يجري على نحو يقرّبه من الإبادة اليهودية إبان الحرب العالمية الثانية. يقول موسز إن الناشطين اليهود كانوا يقرّبون مصير اليهود في ألمانيا أثناء هذه الحرب من مصير الأرمن في سنوات حكم الاتحاد والترقي في اسطنبول، وبعد أن نال الهولوكست ما نال من مكانة بعد الحرب، صار يجري العكس: تأويل الإبادة الأرمنية على نحو يقربها من الهولوكست، وإن تضمن ذلك إنكار فاعلية ومبادرة المجتمع الأرمني ومنظماته وقتها أو التقليل من شأنها.
يتناول موسز، وهو مؤرخ، التكوين السياسي للهولوكوست بالانكباب على تاريخ ألمانيا بين الحربين العالميتين، وتتلخص مقاربته في السطور التالية: «لقد نشأ الهولوكوست تالياً من وحدة دوافع إمبريالية مختلفة. إنه وليد أمة أُحبِطت تطلعاتها الإمبريالية على يد مستعمر متصوَّر [هو اليهود]، وتغذى هذا الوليد من الاستيهامات التعويضية لفترة ما بين الحربين: تحقيق أمن دائم عبر إمبراطورية جديدة ومستعمرات، ثم كطرد، وفي وقت لاحق كتخلُّص من ’الشعوب العدوة‘». لقد جرى تصوُّر اليهود الألمان كمستعمِرين، والألمان من غير اليهود كشعب أصلي مستعمَر. وبصورة مُقْنِعة يُظهر المؤلف أن «الهولوكوست ليس النتيجة الممجوجة للعنصرية العلمية [الخاصة بالنازيين] ولا حتى لألوف السنين من معاداة السامية، بقدر ما هو محصلة هجمات نخب إمبريالية مصابة بالبارانويا على عدو متصوَّر كان يبدو لتلك النخب عازماً على تدميرها، مهما أمكن لهذا التقدير أن يكون مفتعلاً».
على أن هذه الصورة السياسية للهولوكوست، وبخاصة الربط بينه وبين الإمبريالية، والتفكير في معاداة السامية كنزعة عنصرية – على ما ذكر موسز في مقالة له نشرت قبل أيام – ليست هي المعتادة في أدبيات الجينوسايد، بل نقيضها. ديرك موسز أقرب إلى صوت مهرطق في هذا الحقل.
التصوّر المنزوع السياسة للهولوكوست تتوافق مركزيته في التفكير في الإبادات مع صعود صورة الضحية البريء، على حساب صورة المقاوم المسلح التي كانت أيقونية في غير الغرب في حقبة نزع الاستعمار حتى عقدين أو ثلاثة خلت. «البطل» اليوم ليس من يقاتل وقد يُقتَل، بل من يُقتَل دون أن يقاتل. وهذا متصل في تقديري بلبرلة الخطاب السياسي انطلاقاً من المراكز الأقوى عسكرياً، وربما كذلك بتلاقي السلاح والهويات الموروثة، على نحو نجده مجسداً في الإسلامية في منطقتنا دون أن يقتصر عليها. يبدو التماهي متعذراً بمن يُشهِر اختلافه وسلاحه معاً في عالم يزداد تشابكاً.
يميِّز موسز بين صيغتين لما يسميها لغة الانتهاك: لغة غير ليبرالية ولغة ليبرالية. الأولى تسوغ المطالب الأمنية باسم الإثنوس – أو العرق أو القومية – ومنها بخاصة ألمانيا النازية، لكن هذا ينطبق كذلك في تصوري على إسرائيل، التي يقترن تعريفها لنفسها كدولة يهودية بانخفاض شديد لعتبة حاجاتها الأمنية، إلى درجة اعتبار أي فضل قوة يكتسبه الفلسطينيون حولها (أو العرب) خطراً أمنياً ووجودياً، وهو بالطبع ما يخفض من قيمة حياة الفلسطينيين. والثانية هي لغة الانتهاك الليبرالية، وهذه تُحيل إلى الإنسانية والضمير الإنساني كمرجع لها، وذلك منذ أيام بارتولومي دي لاس كازاس، الذي أدان إفراطات الاستعمار الأسباني في العالم الجديد في القرن الخامس عشر (لكن ليس مبدأ الإمبراطورية)، وكذلك اللغة الليبرالية المعتمدة في الغرب المعاصر، وقد تعمدت في «ثورة حقوق الإنسان» التي يفترض أنها جرت بعد الحرب العالمية الثانية عبر محكمة نورنبرغ للنازيين، ومن ثم صدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجينوسايد. لكن ما يوحِّد لغتي الانتهاك في الممارسة هو انضباطهما بتصور للأمن الدائم يدعو موسز إلى تجريمه، وبالإمبراطورية أو التوسُّع الإمبريالي. تصوُّر الأمن الدائم هو ما سوغ جريمة قصف هيروشيما وناغازاكي في اليابان بقنبلتين نوويتين، أو فظائع الحرب الكورية في مطلع خمسينات القرن الماضي، أو الجرائم الأميركية في فيتنام، وإن استند هذا التصور إلى الإنسانية والضمير الإنساني والحضارة. والهوس الأمني للحكم الستاليني في الاتحاد السوفييتي هو ما كَمَن وراء تهجير شعوب وتجويع الأوكرانيين في مطلع الثلاثينات، وقد تسبب بمقتل نحو ثلاثة ملايين فلاح أواكراني فيما سيُعرف لاحقاً بالهولودومور. هنا، جرى الاستناد إلى مبدأ لا-ليبرالي، لكنه لا يُحيل إلى الإثنوس، بل بالأحرى إلى قلعة الاشتراكية المحاصَرة، المهدَّدة بالمؤامرات الرأسمالية والإمبريالية.
ليس واضحاً كيف يمكن أن يجري تجريم الأمن الدائم مثلما يدعو موسز، الذي يوضح أنه جرى توسل المفهوم من قبل أحد الضابط النازيين أثناء محاكمات نورنبرغ لشرح وجوب إبادة اليهود، بمن فيهم الأطفال. إذ بما أن المعوَّل عليه هو أمن يدوم، فإن الأطفال سيكبرون يوماً وقد يثأرون لذويهم المقتولين، لذا يتعين قتلهم كيلا يمثّلوا تهديداً أمنياً في أي وقت. أقول ليس واضحاً كيف يمكن اعتبار الأمن الدائم جريمة، بالنظر إلى أنه يبدو غريزة للدولة السيدة؛ غريزتها الأساسية. وهو ما يعني أن تجريم الأمن الدائم يقتضي تحولاً راديكالياً في النظام العالمي يتجاوز مبدأ السيادة والدول السيدة. على أن كتاب ديك موسز يطرح القضية بقوة، ويقدم أداة تحليلية مهمة يمكن الاستناد إليها في النقد السياسي كما في النضال السياسي.
ديرك موسز
وفي زمن الحرب ضد الإرهاب هذا، وهو يُظهر منطق الأمن الدائم على أكمل وجه، يحوز نقد هذا المنطق أهمية مضاعفة. لا يكاد يُخفي محاربو الإرهاب قلة اهتمامهم بقضايا القانون والعدالة أو القضايا السياسية، مع اهتمامهم الكلي والحصري بقضية الأمن. سوريا مختبر ممتاز للتيقّن من ذلك. هناك معتقلون دواعش في معسكر الهول، منهم أوربيون، لم تُنشأ محكمة خاصة بهم ولا قُدِّموا للمحاكم في بلدانهم. هذه الحالة الحدية تُظهر أرجحية مبدأ الإثنوس (الألماني او الفرنسي أو البلجيكي… الأصلي) على المواطنة المكتسبة (التي يفترض أن تؤمن مساواة في الحقوق وحريات متساوية) في الدولة الغربية المعاصرة. لا يفكَّر في الإرهاب كقضية سياسية، تنشأ عن أوضاع تمييزية في الشرق الأوسط والعالم، بل تحديداً كمشكلة أمنية. ويتيح مدرك الإرهاب تعميم «لغة الانتهاك الليبرالية» لتصير لغة عالمية، يشارك فيه بوتين في روسيا ومحميُّه بشار الأسد في سوريا، ومودي في الهند، والنظام الشيوعي في الصين، والقلعة الصاعدة للرجعية المقاتِلة في الخليج: الإمارات العربية المتحدة، فضلاً بالطبع عن الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتبعية أوروبا. كان جيمس وولسي، رئيس المخابرات الأميركية وقت وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية قد تكلم على حرب عالمية رابعة ضد الإرهاب يمكن أن تدوم أجيالاً. هذا جيل أول قد انقضى، ولا يبدو أن هناك فتوراً في المواجهة، التي اتسع بالعكس الإجماع الدولي حولها. قتْل الإرهابيين وإخراجهم من قوانين الحرب التي تُلزِم بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وحسن معاملة الأسرى وتحريم التعذيب، يبدو جامعاً لهذه الأطراف. الإرهاب هو الاستثناء الذي تقرره لنفسها دول تجد في حالة طوارئ عالمية البيئة الأنسب لدوامها. وعلى كل حال، لا يعتبر الإرهابيون المزعومون أسرى حرب أصلاً، بل هم مقاتلون غير شرعيين، وهذا مثلما اعتبر هتلر القوات الروسية غير مشمولة بقوانين الحرب على ما ورد في كتاب موسز، ومثلما تعاملت القوى الكولونيالية عموماً مع مقاوميها في المستعمرات.
وتحت جنح الحرب ضد الإرهاب، تجري إبادات لا يراها تصوُّر الجينوسايد المتمركز حول الهولوكوست. سوريا هنا مثال أيضاً، ومفهوم الجينوسايد الهولوكوستي – إن جاز التعبير – لا يستطيع رؤية ذلك.
يستفقد القارئ في كتاب ديرك موسز ما ينفتح عليه تشخيص الجينوسايد المتمركز حول الهولوكوست من معالجات قانونية وسياسية، وإن يكن المؤلف أظهر أن تصور ليمكين للجينوسايد مستند إلى صهيونيته وتصورها للعالم كإثنيات وجماعات ثابتة الهوية. في مجالنا، انفتحت معالجة الجينوسايد المتمركز حول الهولوكوست على قومية إثنية في إسرائيل، وهو ينفتح بثبات على تصورات مثل حماية الأقليات، وعموماً على تفكير سياسي متمركز حول هويات ثابتة معطاة سلفاً. وهذا في منطقتنا هو تفكير الإسلاميين وعموم الطائفيين، ويتوافق عموماً ما سميته في تناول سابق «المنعطف الجينوقراطي» الذي هو بمثابة استعداد دائم للجينوسايد. هنا، أعني في عالم يشهد تحولاً هويايتاً، تبدو المشكلات مشكلات كراهية وتعادٍ بين مجموعات لا جذور سياسية واجتماعية له، ويبدو أنه يمكن شرح السياسة بالهويات، ائتلافاتها وانشطاراتها، علاقات الحب والكره بين الجماعات، وليس العكس: أن الهويات تتشكل وتتحلل، وتتآلف وتتنازع، في سياقات سياسية عينية، هي ما يتعين الإحاطة بها. فإذا كانت الهويات هي منابع السياسة، بما في هذه الحرب والإبادة، فإن الحل هو كيانات مستقلة لهذه الجماعات أو حظوتها بحماية دولية، ما يعني وضع نفسها تحت حماية الأقوياء المتاحين. بالعكس، من شأن التفكير في الإبادات على ضوء مفهوم الأمن الدائم، أي سياسات بارانوئية تتوسع في الاشتباه بالجميع، ويقترن في كل حال بالعظمة منسوبة إلى الأمة أو العرق أو الحزب أو القيادة…، أن يتيح مقاربة عقلانية وتقدمية لهذه الجرائم، وأن يجرد أمثال إسرائيل والحكم الأسدي من تطلعات الأبد، التي لا تعني غير مركزة الحكم والدولة حول الأمن لقومية إثنية تؤسس جنونها الأمني على مظلومية وراثية (التعبير لزغمونت باومان)، أو لعائلة مجرمة ومحاسيبها. ما كان لحربين كبيرتين أن تقعا في البر السوري خلال جيلين، وما كان إسرائيل أن تكون في حرب دائمة مع فلسطين وحولها، لولا مطلب الأبد الشاذ وما يقتضيه من أمن دائم.
كان إدراك مشكلات مفهوم الجينوسايد قد حث باحثين متنوعين إلى تطوير مفاهيم مكمِّلة أو مناقضة، منها «البوليتيسايد»، أي الإبادة السياسية، وهو استُحدث لأول مرة من قبل تيد غر وباربرا هرف ليغطي القتل الجمعي لأسباب سياسية، مثلما جرى لنصف مليون على الأقل من الشيوعيين الإندونيسيين في عامي 1956 و1966. ثم مفهوم «الديموسايد»، قتل الشعب على يد الدولة، وقد طلع به رودلف رومل. وكلا المفهومين أكثر نقدية و«تقدمية» من مفهوم الجينوسايد، الهوياتي والطائفي، وإن كان الأخير أشهر بحكم اعتماده من قبل الأمم المتحدة، ثم لكون الأدبيات الغزيرة حول الهولوكوست لا تكف عن إعادة إنتاجه وتعميمه. يؤمل لهذا الوضع أن يتغير بفعل تحديه من قبل أمثال موسز وعدد متزايد من الباحثين. ولعل من المهم أن ننخرط في سوريا والمجال العربي في هذا النقاش المهم، فنستخدم أدبيات الجينوسايد لإضاءة أوضاعنا، ونستند إلى أوضاعنا في نقد أدبيات الجينوسايد.
كتاب مشكلات الجينوسايد جدير بأن يُترجَم إلى العربية، استدراكاً لنقص كبير في ترجمة أدبيات الإبادة من جهة، وإتاحةً لمدخل نقدي واسع الاطلاع لهذه الأدبيات وقليل النظائر.