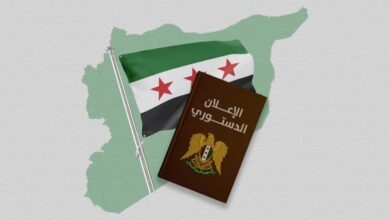لماذا يجب علينا أن نفهم ما يجري في “القدس المحتلة” -مقالات مختارة-

وضعيّة نتنياهو/ مجد كيّال
الاقتراع في إسرائيل لم يعد تعبيراً عن رأيٍ عام ومواقف من مواضيع حارقة. إنما هو رسم لخارطةٍ اجتماعية، يصوّت فيها الناس وفق انتماءات إثنية ودينية ثابتة. لا تمثّل الأحزاب في إسرائيل توجهات سياسية أو اقتصادية، إنما هي وكالات زبائنية تمثّل هويّات فرعية أقلياتية محددة. أما على المستوى السياسي، فالمبادئ الاستعمارية الإسرائيلية مصبوبة كالأسمنت: أغلبية إسرائيلية مطلقة تقدّس يهودية الدولة، ترفض قيام دولة فلسطينية بأي شكلٍ من الأشكال، تؤيّد بقاء وتوسّع الاستيطان، وتؤيّد الضم. وهذا موقف عقائدي إيماني قطعي عند أغلبية نسبتها 70 في المئة من المصوّتين الإسرائيليين. وماذا عن ال 30 في المئة المتبقِّين؟ جميعهم تقريباً يتّفقون على المبادئ الاستعمارية ذاتها أيضاً، إنما من منطلقات علمانية “عقلانية” استراتيجية وسياسية محسوبة. لا من تديّن أو عقيدة. ويُسمّى هؤلاء بأحزاب “المركز” و”اليسار”.
لماذا إذاً، على الرغم من هذا الإجماع اليميني الهائل، يفشل نتنياهو مرةً تلو الأخرى بتشكيل حكومة مستقرة؟ يكمن الإشكال الأساسي في الاصطدام بين واقع المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي السياسة الحزبيّة الإسرائيلية، من جهة، والنظام الانتخابي الإسرائيلي من جهة أخرى، الذي صُمم في حقبةٍ تغيّرت ملامحها الاجتماعية إلى غير رجعة. لم يظهر هذا الاصطدام بين ليلةٍ وضحاها، إنما هو نتاج عملية عمرها أربعة عقود على الأقل. وقد عمل نتنياهو على تكثيف هذه العملية وتسريعها إلى أبعد حد.
صُمّم النظام الانتخابي الإسرائيلي في عهدٍ هيمن فيه حزب كبير واحد (“ماباي” بقيادة بن غوريون) على الدولة والمجتمع بشكلٍ مطلق، دون أن ينافسه أي حزب كبير آخر. في ذلك الوقت، لم تمتلك الأحزاب الصغيرة أدوات ضغطٍ جدية على هذا الحزب المُهيمن، وآثرت أن تبقى في ظلّه لتواصل الاستفادة من الفُتات. مع ولادة المنافسة بين حزبين كبيرين – لأول مرّة في العام 1977 حين استطاع الليكود أن يصعد إلى الحكم – بدأت تتشكّل في إسرائيل سياسة جديدة. من هنا، بدأت تزدهر أحزاب فئوية شرسة، تمثّل هويات دينية وإثنية، وتلعب بين الحزبين الكبيرين، مستغلة الحاجة إليها. مع مرور الزمن، ارتبط تشكّل هذه الأحزاب بالليكود ارتباطاً وطيداً. واستطاع نتنياهو أن يضيف على هذه العلاقة طبقة صمغٍ جديدة. فكيف تشكّل هذا الارتباط؟
ربيع الفئوية الإسرائيلية
منذ النكبة عام 1948 وحتى عام 1992، أُجريت 13 انتخابات إسرائيلية، وكان المشترك بين كل نتائجها أن الحزب الأكبر، والذي تُلْقى عليه مهمّة تشكيل ائتلاف حكومي، حصل دائماً على ما لا يقل عن 40 مقعداً برلمانياً من أصل 120. وهو ما يجعل مهمة ضم أحزابٍ برلمانيّة أخرى للائتلاف الحكومي، حتى تتشكّل أغلبية 61 مقعداً، سهلة. إذ اعتمد حينها تشكيل الحكومة على عددٍ أقل من الأحزاب، وبالتالي ينخفض احتمال تفكيك الحكومة، ويزيد استقرار الحكم. في تلك السنوات، أُجريت الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي بمعدلٍ يقارب مرة كل 3 سنوات ونصف.
منذ الانتخابات التي تلت اغتيال رابين، في العام 1996، لم يستطع أي حزب أن يحصل على 40 مقعداً، وباتت الأحزاب الكُبرى أكثر تعلّقاً بأحزابٍ صغيرة في تشكيل حكومتها. بدأت تظهر صعوبات أشد في تشكيل الحكومات، وبدأت تتسارع وتيرة إجراء الانتخابات. وهو تسارع ثابت يتدهور عاماً بعد عام. في العقد الأخير أجريت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية مرةً كل عام ونصف تقريباً.
منذ تأسيس الدولة الصهيونية، لم يطرأ أي تغيير جدي على نظامها الانتخابي، وباءت جميع محاولات التغيير حتى الآن بالفشل. بعد أن خسر حزب “ماباي” الحكم لأول مرة لصالح الليكود عام 1977، لم يكن التغيير في إسرائيل اقتصادياً نحو فتح السوق فحسب. عندما أدركت مجموعات عرْقية (مثل اليهود الشرقيين) ودينية (مثل الحسيديم) أنها تمتلك قوة تأثير حاسمة في الصراع بين “ماباي” و”الليكود”، بدأت تتولّد أطر حزبيّة تتماهى تماماً مع مجموعات إثنية أو طوائف دينية، وتُحوّل السياسة البرلمانية إلى عملية مقايضة دعم ائتلاف أحد الحزبين الكبيرين مقابل أكبر حصّة من الموارد لهذه المجموعة أو تلك الطائفة. يجدر الذكر أن ازدهار هذه الأحزاب جاء رداً على عقود من الظلم الذي انتهجته قيادة “ماباي” الأشكنازية العلمانية بحق جميع الفئات التي لا تُشبهها فكرياً وعرقياً.
بدأت التيارات الهوياتية والدينية تزدهر، وقد نمت جميعها تحت كنف الليكود. فهمت حركة “الصهيونية المتدينة” في تلك الحقبة ضرورة أن تربط مصيرها بالليكود، وتستغل قدرته على الحكم من أجل دفع وتسريع مشروعها الأساسي، ألا وهو الاستيطان في الضفة الغربية. ثم بدأت الأحزاب المتدينة الأرثوذوكسية تنشق على نفسها أيضاً. تأسس حزب “شاس” عام 1984، والذي يمثّل المتدينين الشرقيين حتى اليوم، ثم انشق المتدينون الأشكناز فيما بينهم. ثم مع الهجرات من الاتحاد السوفييتي، بدأ عام 1996 نشوء أحزاب تمثّل مصالحهم وتنطق باللغة الروسية.
هكذا، بدأت تتشكّل السياسة الإسرائيلية كما نعرفها اليوم. التمثيل السياسي في البرلمان هو تمثيل فئوي، يسن أنيابه دفاعاً عن حصص من الموارد، وقوانين تعني فئات عينية من المجتمع الإسرائيلي. تشكيل الحكومة بات صراعاً تنقض فيه الأحزاب الصغيرة على الحزب الكبير وتنهش منه ما استطاعت. إسرائيل الرأسمالية التي بدأت عام 1977، حولت السياسة إلى سوق مفتوح آخر، يتاجر فيه كلّ بائعٍ بأصوات فئته الدينية أو الإثنية.
إنما في هذه السياسة ميزة أخرى هامة، وهي الميزة التي يعرف نتنياهو كيف يستغلها: يدرك جمهور وقادة هذه الأحزاب، بوضوح شديد، أن كل فئة منهم هي في نهاية المطاف أقلية، وأنها ستبقى أقلية داخل “فسيفساء” المجتمع الصهيوني. وبالتالي فإن أي من هذه الفئات غير قادر على أن يحكم بنفسه، إلا من خلال وسيط يمثّل “الكل” الإسرائيلي. بحثوا عن وسيط يضمن مصالحهم، مقابل ولائهم المطلق له. وجدوا نتنياهو الذي أثبت جدارته بقيادة هذا المعسكر. فعلى الرغم من صفات “ارستقراطية” في سيرته، استطاع أن يؤسس عداءً بارزاً للهيمنة الأشكنازية، من خلال حربه مع المؤسسات النخبوية وعلى رأسها الصحافة. وكانت اللحظة المفصلية التي توّجت نتنياهو قائداً لهذا المعسكر هي لحظة تحريضه على رابين: تحريض أدّى لاغتيال “أب” الأشكنازية العلمانية المسمّاة “يساراً” من جهة، وأجهض عملية “أوسلو” التي رفضها اليمين من جهة أخرى. هذه كانت نقطة البداية.
هوس الاستقرار
نتنياهو مهووس ببناء نظام حُكمٍ مستقر. كان أكثر السياسيين الذين تحدّثوا عن تغيير نظام الانتخاب، ونادى أكثر من مرة لاتباع نظام الثنائية الحزبية، “كما في الولايات المتّحدة” على حدّ قوله. ومع استحالة الوصول إلى اتفاقٍ على تغيير هذا النظام في الظروف المعطاة، سعى نتنياهو إلى فرض واقع الثنائية الحزبية فرضاً. فإذا لم يستطع الليكود أن يتحول إلى حزبٍ يحصل على 50 أو 60 مقعداً في الانتخابات ليحكم وحده، عمل نتنياهو على ربط الأحزاب الفئوية الصغيرة التي نشأت تحت كنف الليكود ببعضها البعض، وبناء ما يُسمى “كتلة اليمين”. وهذه تلتزم بها جميع هذه الأحزاب، وتتعهّد أمام منتخبيها بألا تهجر “الكتلة”، ولا ترتكب الخيانة العظمى بالائتلاف مع حزبٍ “يساري”. لا سيما وأن أحزاب “اليسار” العلمانية الأشكنازية (التي لم تتخلّص بعد من استعلائها المقزّز) لم توفّر فرصةً في معاداة الأحزاب المتدينة، أو معاداة اليهود الشرقيين والاستهتار بموروثهم.
هكذا تحوّل نتنياهو إلى رسول الفئات “المهمّشة”، ويعتبرونه الوحيد القادر على الوقوف أمام المؤسسة القديمة التي كانت جذر اضطهادهم وتهميشهم إبان تأسيس المشروع الاستعماري. وفي طقسٍ يُعاد قُبيل كل انتخابات، تصطف هذه الأحزاب الفئويّة لتُعلن أمام جمهورها انها، وبكل تأكيد، لن تؤيّد أي قائدٍ غير نتنياهو. جمهور هذه الأحزاب طوّر ولعاً بهذا “الملك”، مع الوقت، تحوّل شخص نتنياهو صمغاً يربط هذه الأحزاب ببعضها البعض، ويجعلها تنضوي جميعها تحت كنف الليكود.
وصل نتنياهو إلى اتفاقٍ مع الأحزاب الهوياتية: يحافظ على التزاماته اتجاههم، من موارد ومناصب حكومية وقوانين تعني فئاتهم الاجتماعية، ولا يتنازل عنهم. ويلتزمون هم بالشرعية الكاريزماتية لشخص نتنياهو. هكذا تحوّلت هذه الأحزاب، نوعاً ما، إلى رهينة عنده، إذ لم تعد قياداتها قادرة على التخلّي عنه خوفاً من أن يعاقبها جمهورها المولع به.
إنما هناك عائق واحد كبير في سعي نتنياهو هذا نحو الاستقرار. فمن هم الأعداء الحقيقيون لهذا البناء السياسي الذي يؤسسه نتنياهو؟ هم القيادات اليمينية الفئوية التي لم ترض بدورٍ أقلياتي، وحاولت أن تُخرِج فئتها إلى قيادة “الكل الإسرائيلي”. أولاً، أفيغدور ليبرمان، الذي لم يكتف بدوره كقائدٍ لفئة اليهود الروس، بل يطمع بالوصول إلى منصب رئيس حكومة. وثانياً نفتالي بينيت الذي لم يكتف بدوره كقائد لحركة الصهيونيّة المتدينة، وهو بدأ بالتوجه إلى عموم الإسرائيليين أملاً بأن يصبح رئيساً للحكومة أيضاً. وثالثاً جدعون ساعر، الذي عارض نتنياهو ونافسه (عبثاً) من داخل حزب الليكود حتى الانتخابات الأخيرة، ثم انشق عنه وأسس حزباً جديداً في الانتخابات الأخيرة، رافضاً دوره البيروقراطي الحزبي التقليدي و”الرمادية”، محاولاً أن ينصّب نفسه رئيس وزراء بدلاً من “ملك إسرائيل”.
هؤلاء هم “الفرسان الثلاثة” الذين يعرقلون تشكيل حكومة اليمين اليوم. وثلاثتهم في صلب اليمين العقائدي الإسرائيلي، وقد حصلوا معاً في الانتخابات الأخيرة على 20 مقعداً. وقد التزموا جميعهم أمام ناخبيهم، في طقسٍ مضاد لطقس مبايعة نتنياهو، بأنهم سيرفضون الجلوس معه في أي ائتلاف حكومي. سيحاول نتنياهو الآن أن يُغري حزبين من الثلاثة، ويكسرهما لينضمّا إلى ائتلافه. وبهذا يستطيع أن يشكّل حكومة بأغلبية 65 مقعداً من أصل 120. مهمته الآن أن يُخضِع رأسين سيبذلان كل جهدٍ لاستنزافه حتى آخر قطرة.
لنتنياهو ثلاث أدوات ضغط أساسية على هذه الأحزاب، أدوات جهّزها بنفسه خلال فترة الانتخابات. أولاً، دخل نتنياهو هذه الانتخابات بعد أن شكّل حكومة سابقة مع بيني غانتس (الذي حُسب قائد اليسار). بذلك، أثبت نتنياهو أنه مستعد لإدارة ائتلافٍ حتى مع قوى محسوبة على “اليسار” حفاظاً على حكمه. ثانياً، فكّك نتنياهو القائمة المشتركة وغازل “القائمة العربية الموحدة” بقيادة الحركة الإسلامية ومنصور عبّاس. وقُدّمت القائمة في هذه الانتخابات على أنّها تيّار عربي “براغماتي” مستعد لتأييد نتنياهو مقابل ميزانيات ومنافع للسلطات المحلية العربية. وثالثاً، ساهم نتنياهو بشكلٍ مباشرٍ في إنجاح حزب يمثّل الجناح الأكثر تطرفاً في تيّار الصهيونية المتدينة، وهو حزب “سموتريتش” الذي يعود تاريخياً لتيّار “كاهانا”.
هذه ثلاث أوراق للضغط على “الفرسان الثلاثة” الذين يُعطّلون إقامة حكومة اليمين. ورقة الضغط الأولى، أنهم لو عاندوا ورفضوا دخول حكومة نتنياهو، إنما هم يدفعونه مجدداً لإقامة ائتلاف مع قوة “يسارية”، ويهددون بهذا المصالح الاستيطانية. ورقة الضغط الثانية أنهم لو عاندوا، يدفعون نتنياهو لإقامة حكومة تعتمد على دعم الحركة الإسلامية من خارج الائتلاف، مقابل امتيازات مالية للعرب. وهو سيناريو عبثي، إنما يشكّل ضغطاً كبيراً على الأحزاب المتعنتة الثلاثة. ورقة الضغط الثالثة هي حزب “سموتريتش”. في حال رفضت الأحزاب الثلاث دخول ائتلاف نتنياهو، سيحصل “سموتريتش” على نفوذٍ أوسع بكثير داخل الحكومة التي ستتشكّل. وهو ما سيُضعف مكانة هذه الأحزاب الثلاثة، ويعزز الحزب الأكثر تطرفاً في تيّار الصهيونية المتدينة. كما أن وجود قيادة حزب “سموتريتش” في مناصب حكومية سيضع إسرائيل أمام إشكاليات جدية في محاكمات جرائم الحرب إنْ أجرتها محكمة الجنايات الدولية، لا سيما في ملف الاستيطان.
هذه معركة استنزاف يخوضها نتنياهو ليؤسس حكماً يمينياً مستقراً. يرتبط مصير هذه المعركة بتقديرات الفرسان الثلاثة – بينيت، ساعر، وليبرمان- حول إمكانية كسر شرعية نتنياهو الشعبية. هذه مجازفة كبيرة، لأنها ستورّطهم في حربٍ سياسية مع فئات شعبية واسعة مولعة بنتنياهو. ولكنها من جهةٍ أخرى مجازفة تتسلّح بأمل أن يصمدوا أمام ضغوط نتنياهو مدّة كافية، ويواصلون رفضه إلى أن تنتهي محاكمته بتهم الفساد، ويعوِّلون على وراثته بعد دخوله السجن.
السفير العربي
—————————
القدس: مجتمع يتمرّد على الكارثة/ مجد كيّال
كثافة العدوان الإسرائيلي على القدس في السنوات الأخيرة استثنائيّة، وربما غير مسبوقة. الهبّة الشعبيّة التي تشهدها القدس اليوم تشكّل تمرّداً عفوياً على منظومةٍ صهيونية هائلة، يصعب حصر أطرافها ومداها، تهدف لتدمير المجتمع الفلسطيني المقدسي. هذا التدمير الاجتماعي هو مفتاح إسرائيل الوحيد اليوم لإحكام قمع 350 ألف فلسطيني يعيشون في “العاصمة”، والحفاظ على سيادة يهوديّة في المدينة المحتلّة.
لا يوجد مؤسسة إسرائيلية واحدة، رسمية أو غير رسمية، إلا وتصعّد نشاطها من أجل تهويد القدس وتمزيق مجتمعها الفلسطيني. قوى المخابرات والشرطة والبلدية، ووزارات الداخلية والأمن وجهاز القضاء، هي جهات فاعلة مركزية في هذا العدوان. لكن الصورة أضخم من هذا بكثير: الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات التشغيل والجمعيات الأهلية والصناديق الاستثمارية ومكاتب التخطيط الحضري ورؤوس الأموال (إسرائيليون وفلسطينيون) والحركات الاستيطانيّة وخدمات الرفاه الاجتماعي وجهاز التعليم وغيرها الكثير مما يصعب حصره… كلّها تعمل بكثافة لإحكام السيطرة الصهيونية على المدينة.
الصورة الشاملة
لجان ومكاتب تخطيط حضري تُعيد رسم المدينة بحيث تعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها (بالمستوطنات والطرق والمتنزهات والمشاريع السياحية) وتمنعها من الاتصال بمركز المدينة التاريخي، بينما تسعى لربط المستوطنات ببعضها وبمركز المدينة (خط القطار الخفيف مثلاً)، وتُكثّف إصدار أوامر هدم البيوت، فتُبقي عشرات الآلاف تحت ضغوطات الغرامات المالية المنهِكة الكفيلة بتدمير العائلات اقتصادياً، أو تجبر الناس على أن يهدموا بيوتهم بأيديهم. وزارات صحة وبيئة وسلطات ضريبية تشن هجمات ممنهجة على التجّار لإذلالهم يومياً بالغرامات وإغلاق محلاتهم، وذلك بهدف ابتزازهم لبيع أملاكهم للمستوطنين أو لتسليم شبان مناضلين أو منع نشاط سياسي واجتماعي، وأغراض مخابراتية أخرى. صناديق استثمارية ومؤسسات تشغيل ودمج اقتصادي، بتنسيقٍ حثيث مع رؤوس أموالٍ محليين، تضخ عشرات ملايين الدولارات من أجل “دمج” الفلسطينيين بسوق العمل والاستهلاك الإسرائيلي، وتسعى لإقامة خدمات ومراكز شرائية على مستوى الأحياء، تُغني الناس عن التواصل مع مركز مدينتهم وسوقها. وزارة المعارف ومعها مؤسسات صهيونية تسعى لتصفية الطواقم التدريسيّة في القدس من المربيات والمربّين المناضلات والمناضلين، وتسعى لفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس المقدسية، هذا في ظل معطيات متضاربة حول نسب تسرّب هائلة من مدارس المدينة، تتراوح بين 40 و60 في المئة من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية. منظومة التكافل الاجتماعي في المدينة، التي كانت قائمة في فلك العمل الوطني والنضالي والديني في المدينة، استُهدفت عمداً، وحاولوا استبدالها بخدمات “رفاه اجتماعي” استعمارية، في مجتمعٍ يعيش 80 في المئة منه تحت خط الفقر (وهذا قبل كورونا!).
ومن جهةٍ أخرى محاولات الجامعات والجمعيات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية خلق “نخب” سياسية محلية بديلة، تدّعي تمثيل الناس خدماتياً وتعمل من خلال القنوات الحكومية الصهيونية. هذا كلّه قبل الحديث عن الجمعيات الاستيطانية التي تصرف مليارات للاستيلاء على بيوت المقدسيين وطردهم، ليس في البلدة القديمة فقط إنما في سلوان والشيخ جرّاح وغيرهم، ودفع الناس للتركّز في الضواحي المعدمة المروّعة، ذات الكثافة السكانية الجنونية والظروف الخدماتية والسكنية والاجتماعية المزرية (في كفر عقب مثلاً، يسكن ما يقارب 80 ألف إنسان، بعد أن كانوا نحو 20 ألف في العام 2014 فقط!). علاوة على ذلك، هناك الإرهاب المخابراتي والأمني اليومي الذي يعاني منه أهل المدينة ومئات الاعتقالات التعسفية والمحاكمات شبه الصورية.
ضرب كل ما هو جامع
الهوس الصهيوني بتمزيق المجتمع المقدسي دوافعه معروفة. كتلة بشريّة فلسطينية (350 ألف) هائلة في المدينة على تماسٍ يومي مباشر مع الإسرائيليين، يصعب تهجيرها فيزيائياً من المدينة، ولا يُمكن السيطرة عليها وإخضاعها إلا بتفكيك صلاتها الاجتماعية وقمع جميع إمكانيات تنظّمها وتوحّدها وحراكها، وتشويهها لإخضاعها لمنظومة المواطنة الإسرائيلية. لهذا، شهدت القدس هوساً إسرائيلياً مَرضياً بتدمير كل محاولة تنظيم سياسي مهما كانت صغيرة، وإغلاق لكل مؤسسة أو مركز اهتم بالتثقيف الوطني أو النشاطات الجامعة. حتى العام 2019، أغلقت إسرائيل ما يقارب 90 مؤسسة فلسطينية في المدينة إغلاقاً تاماً، وقمعت ما لا يُحصى من النشاطات الاجتماعيّة والثقافيّة التي جمعت أهل المدينة، من فعاليّات للأطفال أو عروض مسرحيّة أو دوريّات كرة قدم أو حتّى مناسبات من أعراس أو بيوت عزاء. هذا كلّه بموازاة ملاحقة المناضلين وزجّهم في السجون أو اتّباع سياسة الإبعاد عن القدس لشهورٍ طويلة، ونشاط جمعيّات صهيونيّة من أجل تقديم شكاوى للصناديق الأوروبيّة والأمريكيّة المانحة، لمنع تشغيل أي ناشط سياسيّ في مؤسسات تتلقى دعماً من هذه الصناديق.
تتضاعف هذه الممارسات في بلدة القدس القديمة – المركز التاريخي للمدينة وأسواقها وحرم المسجد الأقصى الذي يشكّل قلب المدينة النابض. يحاولون تفريغ الأسواق، وتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وجغرافياً، واعتداءات المستوطنين المتكررة وجولاتهم الاستفزازية في الحرم، وترهيب التجار في الحواري المحيطة بمداخل الحرم خاصةً، كما التواجد العسكري الكثيف فيه، وجعل المكوث فيه خطراً على الشبّان، وتشديد المراقبة والتفتيش على المصلّين، ومحاولة منع النشاطات الاجتماعية في الحرم (قبل أسابيع قليلة، منع الجنود دخول شاب إلى الحرم لأنّهم وجدوا في حقيبته “أنفاً أحمراً” اسفنجياً يُستخدم للمهرّجين في نشاطات الأطفال الترفيهية… إلى هذا الحد!).
باب العامود: محاولة قتل الأجمل!
مع بداية رمضان، بلغت إسرائيل ذروة جديدة في محاولاتها قمع أحد أهم معالم وصورة الحياة الاجتماعية المقدسية: إغلاق مدرّج باب العامود. ساحة ومدرّج باب العامود من أهم معالم القدس، حيّز عام مركزي يُعتبر المدخل الرئيسي للبلدة القديمة، والمرتبط بشوارع تجارية مركزية خارج البلدة القديمة (منطقة شارع صلاح الدين، وطريق نابلس التاريخيّ، ومنطقة باب الساهرة والشيخ جرّاح والمصرارة)، والقريب جداً من مراكز المواصلات الفلسطينية في القدس (كراج باصات رام الله وضواحي القدس وأحيائها الفلسطينية، وكراج آخر لباصات بيت لحم وقراها، ونقطة انطلاق باصات الخليل.) وفي شهر رمضان تحديداً، يتحوّل باب العامود إلى ساحة مهرجانٍ ليلي ساحرة، يجتمع آلاف المقدسيين على المدرجات بعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى، وتدب الروح في الأسواق.
منذ سنوات، بدأت إسرائيل تكثّف الوجود العسكري في باب العامود وتغيّر شكل الساحة، بنت فيه نقاط عسكرية اسمنتية وحديدية يتمترس الجنود فيها للتفتيش والمراقبة والمضايقة في مركز الساحة وفي محيطها، وبدأت تنتهج سياسة مضايقات للزوار وتهديدات، بل ووقعت في المكان عدّة إعدامات ميدانية. أما عشيّة رمضان هذا العام، فقرّرت السلطات الإسرائيلية إغلاق المدرّجات بحواجز حديدية لتمنع الناس من التجمّع فيها منعاً باتاً. عملياً، حاولت إسرائيل أن تقتل أجمل حدثٍ سنوي يجمع المقدسيين ويربطهم ببعضهم البعض، من جميع العائلات والأحياء، وزوّار المدينة المقدسة من جميع أنحاء فلسطين. ومن الصعب فعلاً وصف حُب المقدسيّين والفلسطينيّين عموماً لهذه المناسبة وأجوائها الاحتفالية التي لطالما فرشت بساط فرحٍ فوق الكارثة التي نعيشها.
موجة تمرّد جديدة
في هذا الظرف الاجتماعي المروّع، ومن فظاظة التعجرف الإسرائيلي في القمع، ومن محاولة سرقة أصغر معالم الفرح التي تبقّت لنا، ينشأ جيل آخر تحت ظل الكارثة. كل فلسطيني انفتحت عيونه للحياة على جريمة إسرائيلية ما. واليوم هناك صِبية فُتحت عيونهم على جريمة إحراق الطفل محمد أبو خضير، وهؤلاء يرون حجم الإذلال والقهر الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه لتكسر أرواحنا وكل ما هو حيّ فينا، وتحوّلنا مسوخ نغذّي اقتصاد الاستعمار ومراكزه التجارية، ونتآكل تحت وطأة الفقر والجريمة والتخلّف والتجهيل، وفقدان صلتنا الفكرية والثقافية بتاريخٍ وعمرانٍ، واستمرارية تاريخٍ اجتماعي ثري، وانهيار قيم وأخلاق مناضلة ساعية للعدل بين الناس وللحرية والتضامن الاجتماعي والإرادة السياسية.
استطاعت إسرائيل أن تقمع التنظيم السياسي إلى أبعد حدودٍ ممكنة، وأن تقمع العمل الثقافي والاجتماعي الوطني إلى حدٍ بعيد، لكنها فشلت وستفشل في خلق المسخ المقموع التام. بدأت هذه الهبّة في “تيكتوك” – وسيلة إعلامٍ اجتماعية فيها جيل “التحديات”-، عبرها تحوّل “ضرب المستوطنين” هناك إلى مزحة من قبيل برامج الكاميرا الخفيّة. ولكن بسرعة كبيرة استعاد الخطاب الوطني السياسي مكانته اللازمة. وما بدأ كحركة طفولية مشاكسة غير مسيّسة – نابعة من قهرٍ وكراهية طبيعية لمستوطنين لا يوفّرون أي حقارة لإذلال الناس – تحوّل بسرعةٍ شديدة الى مظاهرات سياسية حاشدة تشتبك مع الجيش الإسرائيلي، وتهاجم وزارة القضاء ومحكمة الظلم في شارع صلاح الدين وتحاول إحراقها.
لكن الأمل والحماس الذي تبعثه بنا هذه الهبّة الشعبية، وغيرها من الهبّات، يجب ألّا يشتت رؤية الصورة الشاملة والعميقة الخطيرة التي تعيشها القدس. هذه المدينة تعيش أكثف وأسرع عدوان استعماري شهدته فلسطين، وأهلها متروكون تماماً دون أي دعمٍ أو مساندة أو رؤية مضادّة للمشروع الصهيوني. كل جهةٍ تسعى لنهضة وطنية في المدينة تُقمع، المساندة الهامة التي حظيت بها المدينة من فلسطينيي الداخل ضُرِبَت مع حظر الحركة الإسلامية ومشروع قوافل الأقصى واستهداف المرابطين عموماً. أما السلطة الفلسطينيّة… فلا يُمكن وصفها إلا بكلمات رئيسها الخَرِف ذاتها.
المشروع الصهيوني في القدس مهول، وينخر أعمق مما نرى وأوسع مما نتخيّل. التصدي له يحتاج إلى جديّة وطاقة وموارد، وإرادة سياسية قبل كل شيء. دعم هذه الهبّة ضروري، والسعي لاتساعها وامتدادها، طبعاً. إنما المطلوب أيضاً قراءة الهبّات السابقة وفهم الإيجابي والمحدود فيها، وقراءة الرد الإسرائيلي عليها ومحاولة توقّعه ومواجهته. وقراءة وفهم صورة القدس… وهي صورة مرعبة دون أدنى شك.
السفير العربي
————————-
لحظة الممكن في فلسطين/ مجد كيّال
لحظات تاريخيّة. القدس تقاوم، وتوقظ بالكرامة والبهاء كل فلسطين ليلتئم الوطن المجزأ ويتمرّد على نكبته، على تقسيمه. في اللد وغزّة وبيت لحم وحيفا والناصرة؛ وطن يتحرّر بوحدة نضاله. هذه اللحظة لنا كلنا، نحن أهل فلسطين، من يعيش فيها ومن نُفي منها لاجئًا.
هذه هي لحظة المُمكن. اللحظة التي تدعونا لنقف على أقدامنا وننسج مرحلةً نحو الحريّة، في مواجهة سواد ذلٍ عظيم شهدناه في العقد الأخير. مرحلة يُمكنّا أن ننسجها بالعمل والمشاركة والمبادرة والتنظيم والصوت والشارع والدعوة.
هذه لحظة لا يُمكننا تفويتها في انتظار قيادات أو أحزابٍ أو قرارات. كل شاب وفتاة، كل كبيرٍ وصغير، كلّنا نتحمّل مسؤوليّة شخصيّة للمبادرة، للنزول إلى الشارع والتظاهر أولًا، لنقدّم لغيرنا نموذجًا في العطاء وبذل النفس في وجه العدوان. ثم نتحمّل مسؤوليّة دعم التحرّكات، بالإسعاف والمحامين والتغطية الإعلاميّة والالتفاف النبيل حول الجرحى والمعتقلين وعائلاتهم، وانتهاز الفرصة لتثقيف الأطفال على حب فلسطين وحب النضال وحب الحريّة، والحوار الصبور مع أهلنا المتردّدين والخائفين والمشكّكين. هذه لحظة تتطلّب منّا التواصل مع من حولنا من أصدقاء ومعارفٍ في محاولةٍ لبناء ما يوطّد تكاتف المجتمع حول النضال.. في مكان العمل، في مكان التعليم، في الحيّ، في القرية.
لا نريد أن “نشارك” في هذه اللحظة التاريخيّة. نريد أن نصنعها معاً. ولا نريدها هبّةً تنتهي بعد العيد. إنما نريدها مرحلةً جديدة نحو الحريّة والكرامة، وخطوة أخرى نحو فلسطين.
——————–
لحظة كل الممكنات وكل المخاطر/ مجد كيّال
أكثر اللحظات التي أشعر فيها بالخوف تبدأ الآن، مع ما يسمى “وقف اطلاق النار”. لأنّي أعرف إن الحرب العميقة والأصعب تبدأ الآن.
الحرب العميقة تنطلق على مستويين. الأوّل هو المستوى الأمني، وقد بدأت إسرائيل تسعى إلى ترميم صورة “الوحش” التي كسرناها. الصحافة العبريّة تقول أنّ الشرطة “صُدمت” من الهبّة الشعبيّة، وهي الآن تحاول أن ترمم “قوّة الردع”. أي أنها تريد أن تستعرض عنفها ووحشيّتها حتّى تُعيدنا إلى مربّع الخوف والخضوع، حتّى تُرهبنا من جديد لئلا نخرج إلى الشوارع مجدداً، ولئلا نرفع نداء الوحدة الفلسطينيّة مجدداً.
بعد اعتقال أكثر من 1500 شابة وشاب في الاسبوعين الأخيرين داخل أراضي 1948، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في 22-05، عن عمليّة سمّتها “القانون والنظام”، ستجنّد فيها وحدات حرس الحدود والشرطة السريّة والوحدات الخاصة وكتائب الاحتياط، من أجل تنفيذ أكثر من 500 اعتقال خلال الساعات والأيّام القريبة بحق “بنك أهداف” محدد، بهدف “تصفية حساباتها” مع الشباب. هذه الحملة غير المسبوقة حجماً هي إعلان حرب يجب ألا يمر بهدوء. قوى القمع الإسرائيليّة مهزوزة ومصدومة، وهي تحاول استرداد وحشيّتها بالعنف والسجون وبتدمير حياة شبابنا. هذا المستوى الأوّل.
ولكن هناك مستوى أعمق وأخطر: حين تهدأ الأخبار، تبدأ المؤسسة الأمنيّة ببسط أذرعها الاجتماعيّة لتعيد صياغة الذاكرة. لمحو القصّة التي كتبها الناس بالشوارع، والتضحيات، ولتكتب مكانها رواية ترسّخ تقسيمنا وتخدم استراتيجية إسرائيل الاستعماريّة.
الناس التي نزلت الى الشوارع، قدّمت نموذجاً رائعاً ومختلفاً في القوّة والشجاعة والتحدّي والوحدة والتكاتف. صحيح. لكن مسؤوليتنا هي أن نقدّم نموذجاً مختلفاً على صعيد آخر أيضاً: ألا نكرر هذه المرّة أخطاء الماضي، وألا نسمح بأن تسرق قصّتنا منّا.
هذه الهبّة الشعبيّة عبارة عن مادّة خام. والسؤال هو من منّا يعرف أن يصنع منها أفضل شكل.
إسرائيل ستجرّب أن تصنع منها ضربة موجعة على مستوى الوعي والخطاب السياسي السائد: ستعطي امتيازات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة لكل من يركض الى حضنها. سيفلتون فلوساً كثيرة ومشاريع كثيرة، حتى يشكّلوا طبقة سياسيّة اجتماعيّة “راقية” ترسّخ القناعة بالمواطنة الإسرائيليّة. وفي السنين القريبة المقبلة، سيجنّدون – ويخلقون – نُخباً اجتماعيّة وأكاديميّة وحقوقيّة وسياسيّة وثقافيّة ورؤوس أموال، جمعيات ومؤسسات وشركات وصحافة، ليسرقوا تضحياتنا – تضحيات الشباب الفلسطيني المسحوق تحت بشاعات الاستعمار وظروفه الاجتماعيّة من عنف وفقر وتجهيل وتهميش. سيحاولون أن يحوّلوا روح الثورة التي في يحملها الناس، والانتماء الفولاذي لفلسطين والقدس والأقصى، يحوّلونه لقصّة “الفلسطينيين في إسرائيل”، ويرجعوا يحكوا لنا عن “خصوصيّة الداخل”. والله يعلم، ربما غدا يأتون لنا ب”لجنة أور” الثانية (1)…
هذه كلّها إمكانيّة مظلمة. لكن هناك إمكانيّة ثانية. الإمكانيّة الثانية هي نحن. ونحن لسنا مما يُستخف به.
بالانتفاضة الثانية كنّا أولاداً صغاراً. جزء منّا لم يكن قد ولد بعد، وجزء منّا كان كبير وإنما غير قادر.
لكننا اليوم منقد نستطيع. وهذا ليس مجرّد واجب. هذه مسؤوليّة حياتنا.
مسؤوليّة حياتنا أن نبني ونرسّخ فكرة وحدة فلسطين. أن نرى المواطَنة قفص وسجن يمنعنا أن نكون كثرة، ونعرف بعضنا البعض، ونتحرّك معاً، ونشكّل قوة سياسيّة حقيقيّة تصيغ حياتها وطموحاتها وأحلامها. مسؤوليّة حياتنا أن نخلق مشاريع، نخلق مبادرات، نخلق دوائر كلّها ترسّخ فكرة إننا شعب واحد، وإننا نريد حياة اجتماعيّة وسياسيّة واحدة حرّة. نضالاتنا لا بد أن تُصاغ بشكل يكسر “خصوصيّة” و”قفص” كل بقعة جغرافيّة. مسؤوليّة أن نبدأ اليوم نبني ونأسس رؤية جديدة تعيش، وتعيد تعريف النضال الفلسطيني بعد سنين من خزعبلات “دولة أوسلو” أو سخافات “المساواة داخل إسرائيل”.
لدينا لحظة مهمّةجداً ، وهي فاتحة الإمكانيّات لكل شيء جديد. ولا بد أن نتحرّك بقوّة وبسرعة، لنحكي، نتواصل، نبني، نفكّر، نفرض خطاب جديد. نرفض حياة الأقفاص، ونجعل كل من يريد أن يتمسّك بالتقسيم يخجل من نفسه. أن نقاتل لنغيّر في قلب الأطر الموجودة، ونخلق أطر جديدة قائمة على مبدأ وحدة النضال الفلسطيني وكسر المعازل. ويجب أن نرى المستقبل أمامنا، مستقبل فيه ابن حيفا وابن خان يونس تلقّون مستوى العلاج الطبي نفسه. ابن القدس وابن الناصرة يدرسون المنهاج نفسه (ويتمردوا على المنهاج نفسه). مستقبل ليس فيه حاجز واحد في كل فلسطين. مستقبل فيه أولاد أم الفحم يلعبون مع أولاد غزّة في حدائق القدس.
أنا لست متفائلاً ولا متشائماً. أعرف أن هذه لحظة مُمكن، وإنه لدينا قدرة أن نصنع منها ما نريد، غن كنا على قدر المسؤولية. ولا بد أن نكون على قدر المسؤوليّة ليس فحسب لنصنع مستقبل أحسن، وإنما من أجل أن يكون حاضرنا وحياتنا اليوم ذوي قيمة حقيقيّة. ولكي نرد للناس التي كانت قبلنا، وناضلت وضحّت وظلمت قبلنا، نردّ لهم حقّهم.
*مجد كيّال كاتب صحافي ومحلل سياسي، ومساهم دائم في السفير العربي، وكاتب أدبي ومسرحي وغنائي، وله:
• “مأساة السيّد مطر”، رواية حازت على جائزة عبد المحسن قطّان 2016
• “الموت في حيفا”، رواية 2019
• “قصص من الحزن العام”، مجموعة قصصية 2019
• “قلبي غابة” أغاني للأطفال 2016
• “أحلى من برلين” البوم غنائي كتب كلماته 2020
• “فهيم” أغاني للأطفال 2021
_____________
1) لجنة اور انشأتها الحكومة الاسرائيلية “للتحقيق” في انطلاق الانتفاضة الثانية وفي مقتل 12 شابا متظاهرا في ايامها الاولى في أم الفحم
السفير العربي
———————-
السلطة الثالثة: حماس بوصفها عقبة أمام تحرير فلسطين/ عبد الوهاب الكيالي
مع كل جولة صراع جديدة بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل، وما يرافق ذلك من سيلان للدم الفلسطيني، يتجدد النقاش حول سبل محاربة إسرائيل الأمثل والأكثر فاعلية. يرافق ذلك، بين الذين يريدون تحرير فلسطين، نقاش حول جدوى العمل العسكري وكلفته وردود الفعل الدولية عليه، مقابل السبل الأخرى، في طقس أمسى شعائرياً بما يفرزه من حدة مشاعر وثيمات من أمثال «الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة» و«لا بديل عن المقاومة العسكرية»، وما إليه من مقولات حول محدودية السبل ويقينية الخيارات التي لا بديل لها. وكما جرى مؤخراً ويجري في كل جولة، تطغى أسئلة حول تعريف حركة حماس، ومحاولات لإعادة تعريفها كحركة مقاومة عسكرية مشروعة في وجه استعمار عنصري واحتلال وحشي وحصار إجرامي. هكذا ينجرّ النقاش التقدمي والتحرري إلى منطق الثنائيات الذي تُفرزه منظومة الممانعة ثقافياً، ما بين خير مقابل شر واحتلال مقابل مقاومة ورضوخ مقابل رفض.
ولكن يتعين على المرء تدوير زوايا حادة عديدة من أجل وصف حركة حماس بأنها شريكة في التحرير الوطني الفلسطيني اليوم، وليست سلطة من بين السلطات العديدة التي تعمل على تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم. كيف لنا أن ننسى سجلّ حماس في الاستفراد بحكم قطاع غزة عبر خمسة عشر عاماً، منذ أن ظفرت بآخر انتخابات فلسطينية حرة في 2006؟ من بداهة القول طبعاً إن شركاء حماس في القيادة الفلسطينية استبطنوا لها سوءاً منذ ذلك اليوم، وعملوا بالشراكة مع إسرائيل على تقويض نتائج تلك الانتخابات بطرق عديدة، أهمها الحصار الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة بأكمله. ولكن ذلك لا يُعفي حماس من مسؤولية حكم القطاع بسلطوية متناهية، وتعفين حياته السياسية، وتجميد الوضع القائم على اقتسام السلطة الفعلية مع حركة فتح، كلٌّ حسب مناطق نفوذه. يصعب على أي مراقب محايد، حينما ينظر إلى واقع «السلطة الفلسطينية»، أن يستثني حماس من هذه السلطة، وألّا يحاسبها على أدائها في السلطة.
وأزيد من ذلك، إن جردة حساب بسيطة لرصيد حماس في الحكم منذ أن تفردت به يعكس نظرتها الدونية للفلسطينيين ولحقّهم في مساءلة حكامهم ومحاسبتهم – عدا عن إسالتها الدم الفلسطيني والاحتفاء بذلك في سبيل الحفاظ على سلطتها. فمن الاستقواء على النساء والبنات، إلى الاعتداء على الكتاب بالضرب، إلى أخيراً الفض العنيف لاعتصامات ومظاهرات حركة #بدنا_نعيش – الحركة التي ظهرت للاعتراض على الواقع المعيشي المتفاقم الصعوبة في قطاع غزة – يظهر لنا معدن الحركة بصفتها سلطة عارية تسعى لاحتكار الحكم في فلسطين، وكبت الاختلاف والتحكم في أجساد المحكومين وآرائهم ومعتقداتهم. وليس مصدر ذلك أيديولوجيا حماس الإسلامية فحسب، وإنما مشروعها القائم على تصدّر وسيادة (إن لم نقل احتكار) الكفاح المسلّح وشرعية حمل السلاح الفلسطيني. معنى ذلك أن مشروع حماس (وبغض النظر عن الأيديولوجيا) هو إقامة دولة (جهة تحتكر السلاح الشرعي تعريفاً) مرادفة للدولة التي تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لإقامتها – بلا أجهزة حربية وعبر المفاوضات السلمية. في هذا المنطق يوجد تسليم ضمني بأن إطار الدولة القومية الفلسطينية المحتكرة للعنف المشروع هو وحده ما يُنهي الاستعمار الإسرائيلي ويُنهي التهميش السياسي الفلسطيني، وتسعى حماس لموقع قيادي في هذه الدولة، إن لم تسعَ إلى تسيُّدها بالكامل.
ولكن هل هذه الدولة اليوم هي فعلاً من يحرر الفلسطينيين ويكفل حريتهم ويمكّنهم سياسياً؟ أكاد أجزم أن التصعيد الأخير في مواجهة التطهير العرقي والتهجير القسري الإسرائيلي على كامل التراب الفلسطيني يدل على عكس ذلك. التصعيد الذي بدأ في القدس، وانتشر إلى الضفة الغربية، وأدى إلى انضمام فلسطينيين الداخل في اللد وعكا وحيفا وغيرها للاعتراض على السياسة الاستعمارية في القدس، يعكس استفاقة كل مكونات الشعب الفلسطيني الذي يقطن فلسطين التاريخية على حقيقة بسيطة: غياب الحق الفلسطيني في تقرير المصير في جميع المناطق الفلسطينية، وتهميش الصوت الفلسطيني وحرمان الفلسطينيين من التمثيل السياسي على يد السلطات الثلاثة التي تتحكم في مصائرهم – أولها وأهمها السلطة الاستعمارية الإسرائيلية، وثانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، وثالثها سلطة حماس في غزة. لقد كانت المواجهة الماضية «انتفاضة وعي في الأساس»، على ما نص بيان الكرامة والأمل، ولا يمكن إنكار السياق الدولي الذي سبق وساند هذه الاستفاقة وبدّى حقوق الفلسطينيين على مصير دولتهم: تقرير هيومن رايتس ووتش عن الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، تقرير منظمة كارنيغي عن التركيز على الحقوق الفلسطينية في ظل استعصاء حل الدولتين، وأخيراً قرار محكمة العدل الدولية النظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة عام 1967. ثم جاء اقتحام حماس لهذه الانتفاضة لغرض تجديد شرعيتها بدم غيرها (ما أتقنته الحركة من عام 2008)، وإعادة المواجهة إلى مربع جرائم الحرب الذي تتقنه إسرائيل وتتفنّن فيه، ليعكس ذعرها تجاه هذا الوعي – بحكم أن حركة حماس لعبت وتلعب دوراً أساسياً في تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم في الأراضي التي تتحكم بها.
إن حلّ الدولة الفلسطينية ليس معطلاً فقط اليوم، بل هو أيضاً لا يحل المشكلة الأساس التي عبر عنها الحراك الفلسطيني الأخير، ألا وهي غياب التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بأكمله؛ تمثيل سياسي يحمي الفلسطينيين ويدافع عن حقوقهم وحيواتهم، ويحيّد أسلحة العدو الأشد فتكاً ولا يستدرجها. إن حركة حماس، بوصفها سلطة فاقدة للشرعية الشعبية، شريكة في هذا الاستعصاء. وهي لم تمتلك تفويضاً شعبياً لخوض هذه الحرب نيابة عن هذا الشعب، ولم تسعَ له. آخر استطلاع رأي أُجري قبل الانتخابات في فلسطين دلَّ على استحواذ حماس أصوات 30 بالمئة فقط من المستطلعين. لا ندري ببساطة كم من الـ250 شهيداً الذي فقدناهم ارتضوا بذلك المصير. وليس لدينا أي دليل على الاستعداد الشعبي لتحمل القصف والدمار وخراب الأعمار والأرزاق في رابع حرب تشهدها غزة منذ تفرُّد الحركة بحكم القطاع. وإذ تذهلنا وتدمي قلوبنا مقاطع أمهات الشهداء وهن يواجهن الفقد الأعز بكبرياء وشموخ، فإن هذه المقاطع لا تصلح مؤشراً على رأي عام مستعد للحرب ومقبل عليها. في مجتمع يمتاز بتنوع وتعدد الشعب الفلسطيني، ليست بيوت العزاء وهتافات المسيرات هي التي تمنح التفويض، بل الفوز بالانتخابات، ومن غير المقبول استخدام الحرب كأداة في حملة انتخابية لرفع الشعبية المنحدرة ما قبلها. مقدار وبشاعة الجرائم الإسرائيلية لا يجب أن يحجب عنا أن سلطة حماس لا تملك الحق باتخاذ قرار الحرب والسلم نيابة عن سكان غزة، وأنها تنتفع (كما جميع سلطات العالم في الواقع) من صوت المعركة الذي لا يعلو صوت عليه، ومن تأجيل المساءلة إلى أجل غير مسمى. هنا يجب التنويه إلى المسؤولية المشتركة لترحيل المساءلة بين سلطة حماس والسلطة الفلسطينية، والتي يقرر رئيسها محمود عباس «الموعد الأنسب» للشعب الفلسطيني كي يحاسب حكامه السابقين ويختار حكامه المستقبليين.
يبقى القول إن حماس تحذو حرفياً خلف نهج حزب الله الخطابي والقتالي والسياسي في لبنان – من إعلان «الانتصارات الإلهية» وتصريحات «ما قبل ليس كما بعد»، إلى تعطيل السياسة ورفع القضايا السياسية إلى مرتبة القداسة، إلى تمجيد الوطن وتحقير المواطنين. وإن لُدِغنا، نحن الذين نؤمن بمشرق أكثر تحرراً وحرية، من جُحر حزب الله في حربه مع إسرائيل عام 2006 واستغلاله لتلك الحرب للانقضاض على لبنان (ولاحقاً على سوريا)، يجب ألا نُلدغ من جُحر حماس في حروبها العدة مع إسرائيل. بين ليلة وضُحاها، رأينا «حركة المقاومة» تتحول إلى ميليشيا فئوية تمارس السلطة العارية بحصانة «شرعية القتال»، وتعيد تعريف العدو والصديق، وتستخدم ترسانة السلاح على الأعداء الجدد – أي علينا. هذا نهج حماس كما هو نهج حزب الله، المنظمتين اللتين استفادتا (وتستمران بالاستفادة اليوم) من استثناء مديد لحركات المقاومة من منطق المساءلة.
في النهاية، يحق للفلسطينيين في كامل الأراضي الفلسطينية أن يختاروا وأن يسائلوا حكامهم، وأن يحصلوا على تمثيل سياسي لائق يدافع عن حقوقهم في أراضيهم. في ذلك الصدد، تحرير الأرض معيار ثانوي مقابل تحرير البشر، ويجب الإقرار بأن حماس عقبة كبيرة أمام ذلك. يُصرّ قادة السلطات الثلاثة في أرض فلسطين على مصادرة الحق الفلسطيني، وإن على مستويات متفاوتة. وتعمل السلطتان الفلسطينيتان على استغلال مناهضة الاستعمار الإسرائيلي حسب المصالح الفئوية لكل منهما. الدولة الفلسطينية المزعومة (سواء بقيادة فتح أو حماس) ليست حلاً للمعضلة التي فجّرت المواجهة الأخيرة. لا نريد دولة فلسطينية تولد لتموت، أو لتكون عبئاً على محكوميها بدل أن تكون سنداً لهم. ليس في المشرق التعيس نموذج لدولة تمكّن مواطنيها سياسياً، ولا لدولة تدافع عنهم، بل على العكس، لدينا نماذج لسلطات ودول لا تتورع عن استخدام السلاح ضد المحكومين الأضعف، وحماس ليست استثناءً في ذلك. ليس على الفلسطيني والفلسطينية الاختيار بين ظلمِ غريب وظلمِ قريب؛ يبدأ التحرير الفلسطيني وينتهي بتحرير الفلسطينيين من جميع سجّانيهم على حد سواء.
موقع الجمهورية
—————————–
انتفاضة فلسطين: تحرير المشروع من الهوية/ ياسمين ضاهر
بعد أسبوع على محاولة الاحتلال اقتلاع أهل الشيخ جراح من بيوتهم، أصبح واضحاً أننا أمام مرحلة جديدة في سيرورة التحرير، والتي حملت العديد من الجولات وكل لكل منها دلالاتها ودروسها. تميّزت الانتفاضة الحالية بتغيير الوعي وتحرير الخيال. سريعاً جداً، ابتعدت هذه الهبة عن الارتباط بمكان او حدث دون غيره، وساهم حلول أسبوع النكبة في خضمّها بأن تتحول أي محاولة لتأطير الحدث بحصره بجغرافيا محددة إلى غباش في الرؤية وتعتيم للحقائق. عادت الإنسانة الفلسطينية والإنسان الفلسطيني ليكونا ضحيتين لكن فاعلتين، تصوّبان رؤاهما وبوصلة قضيتهما، وتؤكدان أنها قضية تحرر وطني، لتتركا خلفهما وصاية القيادات والخطابات القديمة والتقليدية وينتجا خطاباً يتماشى مع خطواتهما وممارساتهما في الشارع.
ليس التغيير لحظياً طبعاً، بل تراكمي. ومن بين الكثير مما راكمته فلسطين وتفاعلت معه على الأرض من تجارب نضالية وأحداث، كانت الثورات العربية في العقد الأخير ذاكرة كفاحيّة هامة ترافقنا وتحمي وعينا، بالذات في ضوء حملات التطبيع التي تقودها بعض الحكومات دون وازع أو ضمير. فقبل أي شيء، وبعد كل ما مرّ عليها، أعادت هذه الثورات في كل مكان في العالم العربي معنى الفعل السياسي، وربطته مع التحرك الفعلي في الشارع، وحرّرت الناس من خوفها الذاتي والجمعي، وجعلت المواجهة مع القمع علانيّة. ولا ننسى أنها استلهمت من انتفاضات فلسطين الشعبية، وبقيت هذه بوصلتها، وهي اليوم تمدّ فلسطين بالمزيد من الإلهام والقدرات الإبداعية.
مرّت القضية بأزمات عدّة في العشر سنوات الأخيرة، قد يكون الخيط الرفيع الذي يربط التعامل معها وردود الأفعال عليها هو نقص القدرة على تعميم خيال تحرري جامع لكل فلسطينية وفلسطيني، بما ينشّط الخطاب والمشروع السياسيين ويعكسهما في تنظيم الناس على الأرض. فالصدمات المتتالية، وما ترتّب عليها من خوف وحنين غير مسيَّس إلى الماضي، كبّلت ولادة خيال صرف وفعلي؛ خيال جامح لممارسة العيش بحرية وكرامة ومساواة في أي مكان على أرض فلسطين. فانحسر الوعي ما بين تأبيد البؤس وأدلجته على يد قيادات متعددة، أو مباعدة المشروع السياسي عن الهوية الوطنية ووضعهما ضمن مسميات الخصوصية، بالذات داخل أراضي 48، وما بين الدولة «النص الكم» التي أصبحت كابوساً ملعوناً يلاحقنا، ومحجّاً لأحزاب مستعدة للتخلي عن غالبية أبناء شعبها وغالبية أرضه بمسميّات الواقعية السياسية. تعود هذه الانتفاضة لتطلق العنان للخيال، وليعزز هذا الخيال غربة وقطيعة متزايدة بين جغرافيات البلاد، وليفرض منطق المساواة كإطار جامع.
وإذا ما اعتبرنا تحرير الخيال والوعي منجز هذه الانتفاضة الأهم، فإن منجزها الثاني هو التحرر من عبء القيادات التقليدية والتقدم دونهم، بل وأحياناً في صدام مباشر معهم. المنجز الثاني مرتبط بالأول، فقياداتنا والمتحدثون باسمنا على مدى عقود عانوا، وإن بدرجات متفاوتة، من محدودية في الإبداع وجرأة في رفع سقف الخطاب، وبعضهم كان يستحدث لغة العجز بذرائع ودودة. لقد شُلّ خيالهم وحاولوا سجننا معهم هناك. وقد جاء نجاح الإضراب، بالذات في أراضي 48، ليتوّج الخروج عن وصايتهم. فقد أظهر الإضراب بوضوح أن إضراباتنا السابقة التزمت السقف الأدنى، سقف الهوية وليس المشروع، وأن قياداتنا أرادت أن يتوّج هذا اليوم حلقة النهاية. هذه المرة، لم تكتفِ مناطق الداخل الفلسطيني بإقفال محالّها على الشوارع الرئيسية، كما جرت العادة، بل اتسم الإقفال بروح التصعيد والرفض، فشاركت به شرائح مختلفة لم تخرج لعملها بل جاهرت وأرسلت رسائل لمشغّليها بأنها «تنضم لأبناء وبنات شعبها». هذا جيل يأخذ مسؤولية شخصية، ولا ينتظر تحريكاً من أعلى الهرم؛ جيل يعرف التكتيك والاستراتيجية، ويعرف أيضاً ألا يأبه بانزعاج البعض من تسمية الأمور بمسمياتها. هذا لا يعني أن حراكات كهذه ليست بحاجة لتخطيط وتنظيم، ولكن هذا ما يفرزه الشارع بشكل طبيعي وعضوي، كي تخدمه أولاً وأخيراً.
كلما احتدّت المواجهات في الشارع اشتدّت الرؤيا وعظُمت، واحتاجت لأن تسكن مساحات فعل وحلم جديدة فينا كأشخاص وكجماعات. وليس صدفة أن نجد اليوم المزيد من الأفراد والتنظيمات ووسائل الإعلام تستعمل مصطلحات ما كانت لتجرؤ على استعمالها لوصف إسرائيل، كالأبارتهايد، والتطهير العرقي، والاستعمار الاستيطاني. هذه مراكمة عمل وسنوات من جهود أفراد ومؤسسات، وفلسطينيين ومناصرين في كل مكان، لم يعبأوا بصراخ الوحدة الذي تُروّج له القيادة الفلسطينية بغرض إفراغ الخارطة وتعبئة الخطاب، بل أشعلوا وحدة في الفهم والتحليل والمثابرة المنهجية وفهم الانتفاضة كحالة تؤسس لما بعدها في صراع طويل.
إنها بداية النهاية. لم تُسَق قبلاً – بهذه الحدّة وبهذه الوتيرة وهذا الوضوح – علاقة المروية بطرفي القصة، وقدرتها على الالتحام حدّ الانحجاب أحياناً بما هو آني ومباشر، وتجاوزها كل التفاصيل الآتية من الميدان لتشكل مشروعاً جامعاً محدداً.
موقع الجمهورية
——————————
صهاينة أحفاد عملاء الـ«غستابو» في الشيخ جرّاح وغزّة/ صبحي حديدي
يصحّ، دائماً في واقع الأمر وليس بين حين وآخر فحسب، العودة إلى تلك المؤلفات التي تتناول الهولوكوست وتبدو غريبة للوهلة الأولى لأنها تضع المرجعية الصهيونية، مؤسسات وممثلين على نحو متّحد، في موقف مواجهة تآمرية ضدّ اليهود أنفسهم؛ وفي حال تواطؤ مع ألدّ أعداء اليهود، في أوروبا على الأقلّ، أي الإيديولوجية النازية ومؤسساتها وجيشها وأجهزتها، وفي ملفّ مأساوي فريد هو الهولوكوست وما سُمّي بـ«الحلّ النهائي». ولا مناص، في المقابل، من أن العودة إلى تلك المؤلفات تكتسي بطابع خاصّ ملحّ، حين تتكشف هذه أو تلك من الركائز الزائفة للصهيونية، أو هذا الوجه أو ذاك من بواطنها الفاشية، تماماً كما يحدث اليوم في القدس وغزّة.
وهذه السطور سوف تبدأ من كتاب يوسيف غرودزنسكي، أستاذ الألسنيات في جامعة تل أبيب، والذي صدر بالعبرية أولاً في سنة 1998، ثمّ في نسخة إنكليزية منقحة سنة 2004، تحت عنوان «في ظلّ الهولوكوست: الصراع بين اليهود والصهاينة في أعقاب الحرب العالمية الثانية». موضوع الكتاب، باختصار شديد كافٍ في ذاته، هو التالي: دور المشاركة المباشرة الذي لعبته المؤسسة الصهيونية وعدد من كبار الصهاينة في مختلف وقائع الهولوكوست، خلال أربعينيات القرن الماضي؛ ودورها في تحويل الفاجعة الإنسانية إلى صناعة دعائية، وكيف انطوى ذلك الدور على تواطؤ مباشر صريح بين بعض القيادات الصهيونية وكبار ضبّاط الرايخ الثالث المسؤولين عن تصميم وتنفيذ ما عُرف باسم «الحلّ النهائي» لإبادة اليهود.
خلاصة مفاجئة بالطبع، ولكن للوهلة الأولى فقط، لأنّ التفاصيل المذهلة التي يسوقها غرودزنسكي، بعد سيرورات تنقيب ونبش وبحص مضنية شملت عشرات الوثائق الصاعقة والأدلة الصادمة؛ تضع المفاجأة جانباً، وتستبدلها بمعادلات منطقية لا خلاف حولها، بصدد استعداد صهاينة تلك الأزمنة للدخول في كلّ وأية صفقة تسهّل إقامة «دولة يهودية» في فلسطين التاريخية، حتى إذا كانت الدروب إلى هذا الهدف سوف تُعبّد بأرواح آلاف اليهود. إلى هذا فإنّ الكثير من الوقائع التي يرويها غرودزنسكي ليست جديدة، وقد أتى على ذكرها عدد من مؤرّخي الرايخ الثالث، وعدد آخر من المؤرخين اليهود أنفسهم؛ لكنّ جديد «في ظلّ الهولوكوست» كان أنه هذه المرّة يتناول التفاصيل وقد وُضعت في سياقات تخصّ جانباً محدداً بعينه.
ذلك الجانب تحتويه الأسئلة التالية: كيف جرى، ويجري، تسويق الهولوكوست لأسباب سياسية صرفة تطمس، وأحياناً تشطب تماماً، سلسلة الوقائع الإنسانية التي تسرد عذابات الضحايا وآلامهم وتضحياتهم؟ وكيف جرى، ويجري، الضغط على ضحايا الهولوكوست أنفسهم، وأحفادهم من بعدهم، للهجرة إلى فلسطين المحتلة رغم إرادتهم غالباً؟ وكيف استقرّ دافيد بن غوريون على الرأي القائل بضرورة تضخيم حكاية سفينة «الخروج» الشهيرة، سنة 1947، كي تشدّ أنظار العالم إلى مأساة اليهود وتستدرّ العطف عليهم والتعاطف مع الوكالة اليهودية التي كانت تقوم مقام دولة الاحتلال الراهنة؟ وكيف أنّ الحقيقة الأليمة خلف حكاية السفينة لا تنطبق، أبداً، على الجوانب الملحمية البطولية كما جرى تلفيقها في رواية ليون أوريس الشهيرة، وفي فيلم أوتو بريمنغر الأشهر…
والملفّ يشتمل خصوصاً على «قضية كاستنر»، التي بدأت فصولها سنة 1945 حين بادر اليهودي الهنغاري مالكئيل غرينفالد (أحد الناجين من الهولوكوست، وكان يومئذ يبلغ من العمر 72 سنة) إلى نشر كرّاس صغير يتهم فيه اليهودي الهنغاري رودولف كاستنر (الذي كان قيادياً صهونياً بارزاً وأحد أقطاب الـ«ماباي»، حزب بن غوريون)، بالتعاون مع النازيين خلال سنتَي 1944 و1945. لقد وافق الأخير، بعد تنسيق مباشر مع الضابط النازي المعروف أدولف إيخمان قائد الـ«غستابو» آنذاك، على «شحن» نصف مليون يهودي هنغاري إلى معسكرات الإبادة، بعد أن طمأنهم كاستنر وبعض معاونيه إلى أنّهم سوف يُنقلون إلى مساكن جديدة؛ حتى أنّ البعض منهم تسابقوا إلى صعود القطارات بغية الوصول في توقيت أبكر، والحصول على مساكن أفضل! وكان الثمن إنقاذ حياة كاستنر وبعض أقربائه، ثمّ غضّ النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى فلسطين.
وهذا الكرّاس تحوّل إلى قضية حين رفع كاستنر دعوى أمام القضاء الإسرائيلي ضدّ غرينفالد، بتهمة تشويه سمعته. وبعد أخذ وردّ أصدر القاضي بنيامين هاليفي حكمه بأنّ كاستنر تعاون بالفعل مع النازيين و«باع روحه للشيطان». المثير أنّ كاستنر قرّر استئناف الحكم، لكنه اغتيل في عام 1957 في ظروف غامضة، الأمر الذي تشكك فيه االمؤرخة الإسرائيلية إديث زيرتال في كتابها «الموت والأمّة: التاريخ، الذاكرة، السياسة»؛ وتعزو اغتياله إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، لأنّ وجوده على قيد الحياة بات مصدر إحراج للدولة. ولكي يفضح القضاء الإسرائيلي، مجدداً، أكذوبة توصيف الكيان الصهيوني بدولة قانون، برأت المحكمة العليا كاستنر بعد وفاته؛ الأمر الذي لم يطمس حقيقة أنّ القضية كانت قد حطّمت – للمرّة الأولى منذ بدء فصول الهولوكوست – الحدود شبه المقدّسة بين الضحية والقاتل، وأسقطت الحصانة المطلقة التي تمتّع بها اليهودي في المسؤولية عن الهولوكوست.
وإذْ يستعرض غرودزنسكي سلسلة الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب، يشير إلى نهج صهيوني رئيسي خلال الأربعينيات مفاده قسر اليهود على الهجرة إلى فلسطين، ويكتب التالي: «بينما جرى ربط تأسيس الدولة بنزاع مع العرب حول الأرض، فإنّ الأمر انطوى أيضاً على نزاع مع اليهود حول البشر. وإذا كان الكثير قد كُتب حول الجانب الأوّل، فإنّ القليل فقط تناول الجانب الثاني، وهذا الكتاب محاولة لسدّ الفراغ عن طريق تركيز عدسة نقدية على الحركة الصهيونية ما قبل الدولة».
وغرودزنسكي يقتبس إسحق رابين (الذي يوصف عادة بأنه «نبيّ السلام»، حتى عند بعض فلسطينيي تمجيد اتفاقيات أوسلو) في مدائحه للعسكريين اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، طواعية هذه المرّة وليس إرغاماً. لكنه يتناسى، إذْ يصعب على مؤرخ مثله أن ينسى، أنّ رابين نفسه لم يشارك، سنة 1993 بصفة رئيس حكومة الاحتلال، في إحياء الذكرى الخمسين لانتفاضة غيتو وارسو إلا بعد أن حرص قبيل سفره على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى «غيتو فلسطيني» بشروط أسوأ مما كان عليه الغيتو الذي ذهب يستعيد ذكراه.
وللراغب(ة) في الاستزادة حول التعاون النازي الصهيوني، ثمة الوقائع التي ساقها سنة 2017، عمدة لندن الأسبق كين لفنغستون بصدد اتفاقية الترانسفير الموقعة في آب (أغسطس) 1933 بين وزير الاقتصاد النازي، والرابطة الصهيونية في ألمانيا، وممثل بنك الأنغلو – فلسطين الذي كان تحت إدارة يهودية. ومن المعروف أنّ تصريحات لفنغستون حول هذه القضية تسببت في فصله من حزب العمال البريطاني. هنالك، أيضاً، كتاب «51 وثيقة: التعاون الصهيوني مع النازيين»، الذي وقّعه الأمريكي الكاتب والناشط في الحقوق المدنية ليني برينان وصدر سنة 2002 عن دار Barricade Books في نيوجيرسي. وهذا كراس يستكمل كتاب برينان «الصهيونية في عصر الدكتاتوريين»، الذي صدر سنة 1983 واستعرض تفاصيل التعاون الصهيوني مع النازية والفاشية وطغاة العالم. أخيراً، وليس آخراً، تصحّ استعادة ألبرت أينشتاين في رسالته إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، سنة 1948، حيث يعتبر أنّ «حيروت»، حزب مناحين بيغن، «مرتبط على نحو وثيق، في تنظيمه وطرائقه وفلسفته السياسية ودعوته الاجتماعية، بالاحزاب النازية والفاشية».
ليست مبالغة، إذن، أن يُرى أبناء وأحفاد عملاء الـ»غستابو» ونازية الأربعينيات، وهم يرتكبون الجرائم والفظائع في حيّ الشيخ جراح وباحات المسجد الأقصى وباب العامود وقطاع غزّة، فضلاً عن اللد وأمّ الفحم وحيفا..
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
———————–
اللد، حيث صندوق الصهيونية الأسود/ صبحي حديدي
في عددها المؤرخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 نشرت مجلة «نيويوركر» الأمريكية الشهيرة مقالة مسهبة بعنوان «اللد، 1948»، كتبها الصحافي الإسرائيلي أري شافيت الذي كان أحد كتّاب صحيفة «هآرتز» ومحسوباً على فريق اليسار، إجمالاً. المقالة سوف تتحوّل إلى فصل في كتاب «أرضي الموعودة: انتصار ومأساة إسرائيل»، سوف يصدر بالإنكليزية أواخر تلك السنة أيضاً؛ وسيحظى بإطراء واسع النطاق من كتّاب ومعلقين يهود في صحف ودوريات أمريكية بارزة.
المقالة/ الفصل في كتاب تروي حكاية بلدة اللد الفلسطينية، من زاوية أولى هي مشروع الصهيوني الألماني سيغفريد ليهمان، الذي وصل إلى البلدة سنة 1927 وعلى نقيض العديد من المشاريع الصهيونية الأخرى الفاشلة، نجح ليهمان في إنشاء قرية شبابية باسم «بين شيمان» ألجأت عدداً من يتامى ملاجئ ضواحي برلين اليهود. الزاوية الثانية تبدأ وقائعها في نيسان (أبريل) 1948 حيث تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية تابعة للجيش الصهيوني، وفي تموز (يوليو) أطلق دافيد بن غوريون عملية «لارلار» التي استهدفت اجتياح اللد والرملة واللطرون ورام الله، كما أصدر إلى موشيه ديان قائد الكتيبة 89 وإسحق رابين ضابط العمليات الأمر بترحيل سكان اللد الـ30,000 بصرف النظر عن الأعمار، بعد ارتكاب مجزرة قضت على حياة 250 من السكان.
ويكتب شافيت: «اللد هي الصندوق الأسود للصهيونية. الحقيقة هي أنّ الصهيونية لم تكن تحتمل مدينة اللد العربية. منذ البدء كان ثمة تناقض جوهري بين الصهيونية واللد. إذا كان للصهيونية أن توجد، فليس للدّ أن توجد. وإذا كان للدّ أن توجد، فلا يمكن للصهيونية أن تولد. وضمن مفعول رجعي، كان الأمر بالغ الوضوح. حين وصل ليهمان مع زوجته ومجموعة أيتام كوفنا إلى وادي اللد، توجّب عليه أن يبصر أنه إذا كانت دولة يهودية ستُقام في فلسطين، فإنّ بلدة عربية باسم اللد ليس لها أن تقوم في وسطها. لقد توجّب عليه إدراك أنّ اللد كانت عقبة تغلق الطريق إلى دولة يهودية، وأنه سوف يتوجب على الصهيونية أن تزيل تلك العقبة».
ورغم أن المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، قبل انقلابه على مجموعة «المؤرخين الجدد»، كان قد فصّل القول في مجزرة اللد وما شهدته من تصفية عرقية؛ فإنّ الإطراء الذي حظي به شافيت كان أوسع نطاقاً وأكثر تشديداً على سمة «الشجاعة» في نقد المؤسسة الصهيونية. الأمر الذي لم يقرّه مؤرّخ وباحث يهودي بارز هو نورمان فنكلستين، في كتابه «نبيذ عتيق، زجاجة مكسورة: أرض شافيت الموعودة»، 2014؛ والذي عرّى ازدواجية قراءة تاريخ النكبة، وكيف أنّ بعض الصهاينة يعتمدون الرفق والترفق في تأويل دوافع قادة الصهاينة خلال ارتكاب المجازر بحقّ الفلسطينيين وتنفيذ عمليات التهجير والتصفية، على غرار ما جرى في اللد؛ مقابل الشدّة والتشدد في الدفاع عن ضرورات إنجاح المشروع الصهيوني في فلسطين، والسعي إلى تنقية الصهيونية من الشوائب.
ومؤخراً عادت مدينة اللد إلى صدارة الأحداث، في أعقاب هبّة القدس على خلفية ترحيل الفلسطينيين من مساكنهم الشرعية في حيّ الشيخ جراح واقتحام باحات المسجد الأقصى؛ وليست هذه العودة سوى الدليل الأحدث على أنّ نبيذ الصهيونية العتيق لم يُعبّأ في دنان مشروخة وزجاجات مكسورة فحسب، بل كانت التعبئة كناية عن إراقة الدماء وتهجير السكان الأصليين وتدمير القرى والتصفية العرقية. وهذه وقائع كبرى لا تفلح العقود، ولا حتى القرون، في حَرْف حقائقها الدامية الدامغة أو طمسها أو إخماد مفاعيلها كلما توجّب أن تُفتح الملفات ويطلب التاريخ إحقاق حقوقه.
أمثال شافيت كثر، لا يخفى، على امتداد تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، حيث صناديق سوداء أخرى لا عدّ لها ولا حصر. النادر والغائب هو الصوت الصافي في إدانة الصهيونية، بوضوح وصراحة ودونما بحّة أو تلكؤ أو تأتأة.
————————–
«حماس» و«فتح» والنظام السوري: نهج التعرّج ومسلك التقلّب /صبحي حديدي
استفظع البعض، ليس في أوساط سورية فقط بل فلسطينية أيضاً، تصريح أسامة حمدان، ممثل حركة «حماس» في لبنان، الذي يشكر فيه بشار الأسد على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، معتبراً أنّ هذا «ليس غريباً ولا مفاجئاً». من جانبه قال خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج: «في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق. مكثنا فترة في دمشق وكانت فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي». وأضاف: «نتمنى أن تستقر الدولة السورية لكل أبنائها ولسنا طرفا في أي أزمة، بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني. نستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معاً».
مواقف التعرّج والتقلّب الانعطاف والارتداد، إلى الحال ونقيضها على منوال الـZigzag في التوصيف الأوضح، ليست جديدة على الحركة؛ بصدد النظام السوري أوّلاً محددة، ثمّ إيران بدرجة تالية، ونظام عبد الفتاح السيسي في مصر ثالثاً، فضلاً عن الولايات المتحدة رابعاً، واللائحة طويلة وليست البتة قصيرة. طريف، إلى هذا، أنّ شكر حمدان لرأس النظام السوري نهض، بصفة حصرية وبناء على إلحاح المذيع السائل، على لقاء الأسد مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية (حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الصاعقة، النضال الشعبي، فتح الانتفاضة، جبهة التحرير، حركة فتح)؛ لكنّ «حماس» لم تكن مدعوة، ولم يكن شاقاً استدعاء حمدان نفسه من بيروت إلى دمشق لحضور الاجتماع.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، ويذكّر، فإنّ صفحة الأسد على «تويتر» ما تزال تحمل تلك التغريدة الشهيرة، التي تعود إلى عام 2016: «كنّا ندعم حماس ليس لأنهم إخوان، كنّا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة، وثبت فى المحصلة أن الإخونجي هو إخونجي في أي مكان يضع نفسه فيه». وأمّا الإخونجي الأوّل المقصود بهذا الفرز، فهو مشعل نفسه وشخصياً، ليس لأنه كان جليس الأسد طوال إقامة قيادة الحركة في سوريا، وحتى مغادرتها أوائل سنة 2012، فقط؛ بل كذلك لأنّ ما سيتكشف ذات يوم من وثائق الانتفاضة السورية سوف يُظهر أنّ مشعل كان، في سنة 2011 وبعد أسابيع قليلة على انطلاق الانتفاضة، رسول الأسد إلى وجهاء الغوطة للتوسّط حول وقف امتداد التظاهرات إلى الأحزمة الشعبية (الإسلامية، غالباً وتاريخياً) التي تطوّق العاصمة دمشق.
خلال الفترة ذاتها، تمّ اغتيال كمال غناجة، القيادي الحمساوي الذي تُجمع معظم المعلومات أنه كان رجل الظلّ الذي ينوب عن محمود المبحوح(اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في دبي خريف 2010)؛ مع فارق أنّ تصفية غناجة جرت في بلدة قدسيا على تخوم دمشق، وذلك حين كانت مدرعات اللواء 105، التابع للحرس الجمهوري، تحاصر قدسيا. وكما طوى «حزب الله» اللبناني أمر التحقيق في اغتيال عماد مغنية في قلب العاصمة السورية، سنة 2008، فإنّ «حماس» طوت اغتيال غناجة رغم أنها كانت قد التزمت بإجراء تحقيق شفاف وإعلان النتائج. هنا أيضاً، وعلى منوال ما سيشهده مخيم اليرموك الفلسطيني من فظائع ارتكبها النظام السوري، ابتلعت «حماس» الإهانة فوق الجرح، وجنحت إلى خيار الـZigzag إياه، وكفى الله المؤمنين شرّ الخصومة مع إيران/ عبر مخاصمة الأسد!
حركة «فتح» شقيقة «حماس» والشقّ الأوّل في المعادلة التنظيمية والسياسية والحكومية التي تتسيد المشهد الفلسطيني الداخلي اليوم، ليست أقل تعرّجاً وتقلّباً وانعطافاً وارتداداً بصدد الموقف من النظام السوري؛ خلال فترة رئاسة محمود عباس بصفة أخصّ؛ التي كانت أيضاً واحدة من أسوأ مراحل تكلّس الحياة الداخلية في «فتح». ولقد شهدت أيضاً انكماش الخيارات الداخلية والإقليمية والدولية، وانحطاط مدوّنة المقاومة والتاريخ النضالي الفتحاوي إلى حضيض غير مسبوق من الانعزال عن الشارع الشعبي الفلسطيني، والارتهان إلى مؤسسات السلطة، واستئناس الفساد أو الانخراط في ميادينه المختلفة.
وحين تلقت «فتح» صفعة شعبية كبرى في الانتخابات التشريعية اليتيمة سنة 2006 حين حصدت «حماس» 76 مقعداً وتركت لـ«فتح» 43 مقعداً؛ لم تكن هذه الأغلبية ناجمة عن تفضيل شعبي للحركة الأولى على الثانية، بقدر ما كانت عقاباً للثانية عبر تعزيز الأولى. ولقد قيل يومذاك، على ألسنة الكثيرين في «فتح» أساساً، إنّ حكومة اسماعيل هنية التي نجمت عن الانتخابات هي استطالة بيروقراطية للجهاز الأمني ـ العسكري الحمساوي؛ وتغاضى القائلون عن حقيقة أنّ حكومة سلام فياض انقلبت، بدورها، إلى استطالة بيروقراطية للجهاز الرئاسي الذي سكت تماماً، لكي لا نقول إنه شجّع، الذروة القصوى الدموية التي بلغتها أجهزة محمد دحلان في غزّة، اقتفاءً للغرض الحمساوي ذاته في الواقع: إبطال الفعل الديمقراطي الشعبي الذي جاء بـ«حماس». واستطراداً، إذا جاز اعتبار حكومة هنية حمساوية أصولية صاحبة أجندات إيرانية وسورية، ألم يكن من الجائز اعتبار حكومة فياض فتحاوية انتهازية صاحبة أجندات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية؟
وحين وقع «انقلاب غزّة» الشهير، وتغدى الحمساويون بفتحاويي محمد دحلان قبل أن يتعشى الأخير بهم، تحدث محمود عباس عن «مخطط» وصفه هكذا: «سلخ غزة عن الضفة الغربية وإقامة إمارة أو دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب»؛ وذلك «لتحقيق حلم مريض وأهوج في إقامة إمارة الظلام والتخلف، والسيطرة بقوّة الحديد والنار على حياة أبناء غزة وفكرهم». ولكن… ما الذي كانت كانت الإمارات الأخرى، الفتحاوية هذه المرّة، حيث الفساد والنهب والقهر، تسعى إلى تحقيقه؟ الحلم النظيف المستنير المعافى، بدولة الحقّ والخير والجمال؟ وعباس، الذي ألمح إلى ارتباطات «حماس» الخارجية، لماذا تناسى أنه زار دمشق لا ليبيع الزيارة (حتى في بُعدها الرمزي المحض) إلى الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، أو ليساوم عليها مع بعض الأطراف العربية، فحسب؛ بل أساساً كي يعيد تسويق دور ما للرئاسة الفلسطينية في ما يخصّ الحوارات الأعرض نطاقاً مع طهران ودمشق، وكي لا يكون مشعل هو الضيف الوحيد على تلك الحوارات.
على مستوى «فتح» الحركة، إذْ قد يساجل بعض الفتحاويين طيّبي القلوب بأنها «مستقلة» عن السلطة، في سنة 2013 سافر الأخ شريف علي مشعل (عباس زكي، في ألقاب نضالات أيام زمان!) إلى دمشق، مبعوثاً من عباس؛ وشدّد هناك على «تضامن الشعب الفلسطيني مع سوريا في مواجهة العدوان الذي تتعرّض له» وأنّ «استهداف سوريا استهداف للأمة العربية، لأنّ ما يجري من استنزاف لمقدّرات شعبها وجيشها يأتي في سياق مخطط أكبر يرمي إلى تقسيم دول المنطقة وإضعافها خدمة لمصالح إسرائيل». وحين كان مخيّم اليرموك يخضع للحصار والتجويع، لم يجد زكي أيّ حرج أخلاقي في القول: «الأحداث التي تشهدها سوريا لم ولن تغيّر نهجها إزاء أشقائها الفلسطينيين الموجودين في سوريا، بل زادتهما لحمة وتماسكاً في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدفهما معاً»!
وحين كان الأسد يستقبل ممثلي الفصائل في دمشق، كانت أجهزة الأمن العسكري وعناصر ميليشيا «أبو الفضل العباس» تنفّذ حملات اعتقال واسعة في خان الشيح، الذي تقطنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين؛ وذلك لأنّ بعضهم، حمساويين وفتحاويين كما للمرء أن يتخيل، حاولوا التظاهر تضامناً مع القدس وغزّة ضدّ العدوان الإسرائيلي. لا «فتح» محمود عباس وعباس زكي وعزام الأحمد، ولا «حماس» خالد مشعل وإسماعيل هنية واسامة حمدان، رمت النظام السوري بوردة؛ مع التنويه بأنّ الذريعة الكبرى لدى الحركتين، بصدد تبرير نهج التعرّج ومسلك التقلّب، هي تلك التي تلحّ على أنهما ليستا… على كوكب آخر!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
————————
فلسطين ومجلس حقوق الإنسان: حيثيات 1948
صبحي حديدي
خلال اجتماع استثنائي، عُقد مؤخراً كما هو معروف، اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً لافتاً بتشكيل لجنة دولية خاصة تتولى التحقيق في انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما إذا كانت ترقى إلى مستوى جرائم حرب؛ ليس في قطاع غزّة خلال العدوان الهمجي الأخير فقط، وإنما في الضفة الغربية وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثمة، في حيثيات التالية المتصلة بالواقعة، ما يلفت الانتباه إلى جوانب كثيرة لا تقتصر على المجلس ذاته وإشكالياته العديدة، بل تشمل أيضاً مفاهيم حقوق الإنسان كما تعتمدها المنظمة الأممية، وتصادق عليها ديمقراطيات عديدة غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً.
هنا بعض تلك الحيثيات:
ــ الجلسة انعقدت بناء على طلب باكستان وفلسطين؛
ــ تمّ تمرير القرار بأغلبية 24 صوتاً، مقابل، 9 وامتناع 14 عن التصويت؛
ــ الدول الرافضة كانت النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي؛
ــ الدول الممتنعة عن التصويت كانت الهند وجزر الباهاما والبرازيل والدانمرك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا؛
ــ ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوضحت أنّ الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب، وأوضحت وأضافت أن<المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.
ــ الولايات المتحدة (التي لا تملك حقّ التصويت لأنها اليوم عضو مراقب) أعربت عن «أسف شديد» معتبرة أنه «يهدد بعرقلة التقدم الذي تمّ إحرازه» بواسطة الجهود الأمريكية؛ وأما بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال فقد اعتبر أنّ القرار «مخز ويعبّر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل» وثمة في المجلس «أغلبية معادية لإسرائيل وغير أخلاقية».
وإذا لم تكن ثمة مفاجأة، ولا دلالة كذلك، في لائحة الدول الرافضة، لأسباب لا تقتصر على محاباة دولة الاحتلال بل تذهب أعمق نحو تواريخ تورّط بعض الرافضين في انتهاكات لا تقلّم فظاعة؛ فإنّ الكثير من الدلالة يكتنف بعض الدول التي امتنعت عن التصويت (الهند بصفة خاصة، ثمّ اليابان تالياً، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا ونيبال وبولندا…). وقد لا يكون المرء مضطراً إلى استرجاع منعطفات تاريخية لبعض الممتنعين قد تُلزمهم بعدم الامتناع عن التصويت (موقع الهند ضمن ما سُمّي ذات يوم خيار «عدم الانحياز» في العلاقات الدولية القطبية، أو فرنسا بصدد «السياسة الشرق – أوسطية التي اقترنت بالجنرال دوغول، أو فلسفة «الحياد الإمبراطوري» في مدوّنة السياسة الخارجية لليابان…). غير أنّ قراراً من الطراز الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان مؤخراً إنما يبدأ في واقع الأمر من إعادة توصيف جريمة الحرب في ضوء معطيات تكنولوجيا التدمير العسكرية المنفلتة من كلّ عقال، ويطمح إلى تثبيت معايير الحدود الدنيا لوقف الإفلات من الحساب.
وتلك مقاربة لا تخفف وطأة تلك المشكلات البنيوية الأعمق التي اكتنفت مفهوم حقوق الإنسان في تأويلاته الأممية المختلفة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة؛ ليس من دون إسناد القوى العظمى على اختلاف عقائدها، وحتى حين كانت قطبية الحرب الباردة تهيمن تماماً على مشهد العلاقات الدولية. فالنصّ الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في قصر شايو، من ضواحي باريس، مطلع كانون الأول (ديسمبر) 1948؛ سوف يدخل التاريخ السياسي المعاصر تحت تسمية «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وعلى أسس 30 مادة، ولغة كونية عامة وتعميمية، مهدت الكثير من الدروب المتعرجة أمام اعتصار «شرعة دولية» حول حقوق الإنسان، لن ترى النور قبل سنة 1966.
هنا بعض الحقائق التكوينية، التي صنعت وتواصل صناعة الكثير من إشكاليات المفهوم في منطوقه الأممي:
1 ـ ليس دقيقاً التأكيد، الشائع، بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت عليه بالإجماع، لأنّ التصويت أسفر عن 48 دولة لصالح الإعلان، و8 دول ضده. ولو كان عدد الدول النامية («العالم الثالث» في العبارة السالفة) كما هو عليه اليوم في المنظمة، فإنّ من الصعب تخيّل تحقيق هذه النسبة في التصويت، وربما من الصعب تخيّل الإعلان وقد فاز بالتصويت أصلاً.
2 ـ الجهات التي صاغت النصّ كانت هي ذاتها القوى الغربية الكبرى، الضالعة في سياسات استعمارية هنا وهناك في العالم، والتي كانت تمارس انتهاك حقوق الإنسان (وحقوق الشعوب، في عبارة أدقّ) حتى وهي تنخرط في معمعة النقاشات المحمومة حول هذه الصيغة أو تلك من فقرات الإعلان نفسه. لم يكن غريباً، في السياق، أنّ المؤتمر التأسيسي لدول عدم الانحياز (باندونغ 1955) امتنع عن إبداء أيّ دعم سياسي للإعلان، واكتفى رؤساء الدول (وكانوا من الكبار للتذكير: نهرو، عبد الناصر، تيتو…) بالقول إنهم أخذوا به علماً!
3 ـ بعض السبب يعود إلى أنّ الإعلان يسكت تماماً عن حقّ الشعوب في تقرير مصيرها (الأمر الذي يتناقض على نحو صارخ مع الفقرة الأولى التي تقول: «يولد البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق»). أكثر من ذلك، يسوّغ الإعلان مفاهيم الوصاية والانتداب والهيمنة الاستعمارية، حين يحثّ الدول الأعضاء (المستقلة و/ أو الاستعمارية) على احترام حقوق شعوبها مثل حقوق الشعوب والأراضي الواقعة تحت سلطتها القانونية (أي: الدول غير المستقلّة و/ أو المستعمَرة).
4 ـ في توصيف مفهوم حقوق الإنسان، ينطلق الإعلان من شخصية الإنسان الغربي وحده، أي من قِيَمه وثقافته وأعرافه وفلسفاته، من حضارته التي كانت هي التي انتصرت (على نفسها!) بعد الحرب العالمية الثانية، حين انعقد مؤتمر سان فرنسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة، وإطلاق «النظام الدولي الجديد»… آنذاك، وليس عام 1991 في أعقاب «عاصفة الصحراء» أو 2001 بعد انهيار برجَي التجارة في 11/9، أو 2003 بعد غزو أفغانستان والعراق، أو 2011 حين تفجرت الانتفاضات الشعبية في العالم العربي. الإعلان كان وليد تلك البرهة الإجماعية الغربية بامتياز، ولم يكن مدهشاً بالتالي أن تكون «صورة العالم» كما يصفها الإعلان، هي صورة العالم كما رسمتها الحضارة الغربية.
5 ـ إنها، بمعنى النقلات الحضارية الكبرى، صورة تبدأ من اليونان الإغريقي الكلاسيكي، ثم تمر» من روما الإمبراطورية، فالكنيسة الكاثوليكية. هنالك أيضاً عصر الأنوار، الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، الآلة البخارية، الثورة الصناعية، الحداثة. هنالك، أيضاً، الحروب الصليبية «اكتشاف» أمريكا، محاكم التفتيش، الفتوحات الاستعمارية، الإمبريالية، الفاشية، والنازية. هنالك، بمعنى آخر، الصالح مثل الطالح، والكوني مثل المحلي، والعامّ مثل الخاص…
وهكذا فإنّ وثيقة 1948 لم تكن قادرة على تمثيل حصيلة إنسانية مشتركة حول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم تكن خالية من الثغرات التي ترقى إلى مستوى المساوئ البنيوية، تماماً مثلما كانت حافلة بالمحاسن التي تبرّر القول إنها خطوة كبرى وأولى على طريق صياغة تعاقد إنساني عالمي حول حقوق الإنسان. ولم يكن غريباً أن يرفع الغرب رايات حقوق الإنسان في ذروة دعمه ومساندته، بل وأحياناً قتاله إلى جانب، أعتى الأنظمة الاستبدادية في العالم الثالث عموماً وبلدان الشرق الأوسط والثروات النفطية خصوصاً. ولم تكن ازدواجية معايير الدول التي صوتت ضدّ، أو امتنعت عن التصويت، على قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، ناجمة فقط عن الخشية من المسّ بمصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى دول مثل بريطانيا أو النمسا أو ألمانيا، غير أنّ حيثيات مفهوم حقوق الإنسان ذاته لا تشجّع على الرفض والامتناع فقط، بل تحثّ أيضاً على تأمين الإفلات من العقاب.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
————————-
14 مليون صوت وبشار حانق/ محمود الوهب
أدرك من استمع إلى خطاب بشار الأسد، بُعَيْدَ الانتهاء مما سميت مهزلة الانتخابات، من اللغة البذيئة التي استخدمها، كم هو مقهور وحانق. ما يعبِّر عن حجم الرعب الذي يعبث بداخله، ويلفُّ مستقبله الغائم في ظل تحدّيات الأوضاع السورية التي صنعها بيديه، أو بسبب رعونته التي قادت البلاد إلى ما هي عليه. تنتظر حلولاً، ولكن لا حلول بوجوده، فتراه مرتبكاً بائساً أمام انكشاف عورات النظام الذي يرأسه، فعلى الرغم من حجم الاحتقار الذي أبداه وأجهزته الأمنية والعسكرية والحزبية، للشعب السوري وفئاته كافة، من خلال محاولات تصغيره، وإذلاله بجعله يمارس تفاهات لوازم انتخاباته التي تجاوزت أبسط القيم الأخلاقية، فقد جعل المواطن يمارس، بإرهاب أدوات النظام، أفعالاً لم يكن ليفعلها لو أنه يمتلك حرّيته، وحقه بالدفاع عنها. ولم يكتف النظام بمخبري الأجهزة والشبّيحة و”زلم” أثرياء الحرب، بل ألزم رجال الدين الذين يفترض أنهم يمثلون قيماً أخلاقية تتسم بالقدسية، فسيَّرهم بمظاهرات، كالشبّيحة والطبّالبين وسواهما، يتضرّعون إلى الله، بأسلوب شعبوي، أن يحفظ لهم قائدهم. وأتبع ذلك بحفلات دبك ورقص وتهريج، وتمجيد للرئيس الذي لا مثيل له إلا في الدول المشبعة تخلفاً واستبداداً. وكان أبوه قد أخذ أسلوب تلك الانتخابات عن كوريا الشمالية المأخوذة أصلاً من شكل انتخابات الاتحاد السوفييتي السابق، وكانت سبباً في إسقاطه إضافة إلى أسباب عديدة أخرى! وعلى الرغم من وجود مرشّحين خلَّبيين كثر بقي منهم اثنان، تصدَّق عليهما بحفنة أصواتٍ تكاد ألّا تذكر ليشير إلى الفارق الكبير بينه وبين أي مرشّح آخر من أبناء الشعب، وكأن هؤلاء في أسوأ حالاتهم مقطوعون من غصنٍ يابس، فلا أهل لهم، ولا أصحاب، ولا أسر أو عائلات أو أنصارا يمنحونهم مقداراً معقولاً من الأصوات.. والحقيقة أن المرشَّحَيْن ارتضيا على نفسيهما أن يكونا ذلك القرد الذي كنا نتفرج عليه، أيام زمان، إذ كان “القرداتي” يدور به على تجمّعات الناس، ليجمع بعض النقود مقابل حركاتٍ يؤدّيها القرد. وليس ذلك فقط، بل جاءت كل خطوة قامت بها تلك الأجهزة هزيلة، وأعطت عكس مبتغاها. حتى إنَّ بصمات الدم التي قام بها بعض العسكريين كشفت عن حالة التباهي بالغشّ والتزوير دونما أي خجل أو اعتبار لأية قيمة قانونية أو اجتماعية أو أخلاقية.
جمع متابعون حجم الأصوات التي نالها، وطرحوا وقسموا وقارنوا، ثم تبينوا أنها فاقت عدد سكان سورية كباراً وصغاراً، حتى إنَّ عدد سكان سورية نفسه قد ازداد ليبلغ الضعف أو دونه بقليل. وتجدر الإشارة إلى أنَّ ترامب وبايدن حصلا مجتمعين في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على نسبة 40% من عدد سكان الولايات المتحدة البالغ نحو 320 مليون نسمة، وهؤلاء هم الذين يحق لهم الانتخاب، علماً أن المجتمع السوري أكثر شباباً، فأعمار من هم دون سن الانتخاب أكثرية، يعني أن نسبة من يحق له الانتخاب أقل من الأرقام التي ظهرت. وإذا ما افترضنا أن انتخابات الأسد كانت حامية بالقدر نفسه، ونزيهة بالمعايير ذاتها، فيكون عدد سكان سورية أكثر من 35 مليون إنسان من دون حساب أكثر من 12 مليون مهجر، تحت طائلة الموت، أو مقيم خارج مناطق سيطرته لنظامه، فهؤلاء جميعاً، في عُرْفِ بشار، ثيران هائجة وخونة وعبيد للدولار، كما وصفهم خطابه!
يعلم الأسد قبل غيره أن تدمير سورية الذي جرى على يديه، وأيدي من وصفهم بالإخوة، (الروس والإيرانيين)، لأن هؤلاء طالبوه بإجراء انتخاباتٍ حرّة وديمقراطية، تسمح بتداول السلطة، ولا أحد يعرف ما الذي أخافه حينذاك، إذا كان قادراً بالفعل على حيازة 14 مليون صوت حلال، وليدفع جيشه لمواجهة المطالبين بالانتخابات الحرة! ثم ليدير ظهره للمبادرات العربية التي لم يكن جوهرها غير اللجوء للانتخابات الديمقراطية حلاً سورياً سورياً.
لغة بشار الأسد في ذلك الخطاب، وعلى الرغم من كل الارتياح الذي ظهر على وجهه المحسَّن بالبوتكس، أكّدت أن النظام فشل في تجميل صورته، فلم يستطع تمويه عملية الانتخابات لتكون طبيعية. وإذا كان أمر تزوير الانتخابات لا يهمه، إذ هي تجري على هذا الشكل منذ تولى والده السلطة. وتؤكد لغة الخطاب الغاضبة أن النظام يقف اليوم وجهاً لوجه أمام الاستحقاق السوري المؤجّل.. وهو إعادة الإعمار، وترحيل الاحتلالات، واستعادة ثلث الأراضي السورية بثرواتها الجمّة من شاغليها ومستثمريها! وإعادة لم شمل السوريين على أرض وطنهم، التي هي في صلب الحلول المنتظرة، وإن كان الخطاب يحمل، في نبرة تخوينه، فكرة الاستغناء عن المهجّرين. وقد يبدو هذا الأمر طبيعياً لمن لم يفهم الوطن إلا مزرعة له ولأسرته وللضاربين بسيفه. أما إذا كان يعوِّل على الروس، وعلى حدوث اتفاق بين أميركا وإيران، لتعود الأخيرة، وقد استردّت أنفاسها، ومع عودة العرب الذاهبين إلى التطبيع معه، ومع إسرائيل، يمكنه الاستغناء عن المهجّرين أجمعين، وتقديم شيء ما لهؤلاء الذين دبكوا، ورقصوا، وتصاغروا أكثر مما ينبغي، فتلك أيضاً مجرّد أوهام يكذّبها الواقع.
وأخيراً، إذا كان خطاب رأس النظام السوري يوضح أن الانتخابات لم تفكك له العقد، فلا شكّ أن الأمر منوط بموازين القوى الدولية، وبمصالحها، وبمدى احترام الدول الكبرى قرارات الأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2254. بيد أن الأمر مرتبط أيضاً بما يمكن أن تبدو عليه المعارضة من وحدة وتماسك ومرونة تحالفات، وتأكيد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والتفاف حول شعاراتٍ ديمقراطيةٍ تحقق المواطنة الكاملة، وتعمل في إطار تلك الوحدة على تجاوز أي لونٍ من ألوان التمييز بين المواطنين من الذي كان سائداً زمن الاستبداد، فعلى إنجاز ذلك يتوقف الكثير، ولا مجال للانتظار، فالزمن لا يرحم.
العربي الجديد
———————
الدراما في تل أبيب والبهجة في واشنطن/ أسامة أبو ارشيد
إذا نجح تحالف اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي، فعلاً، في تشكيل ائتلاف حكومي جديد يطيح سيطرة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على الحياة السياسة على مدى الاثني عشر عاماً الماضية، فإنهم سيُقابلون بارتياح كبير في أوساط الإدارة الأميركية، ولكن من دون إبداء مظاهر الفرح والاحتفال. لا توجد معطيات، حتى الآن على الأقل، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ساهمت في جهود محاولة طيِّ صفحة نتنياهو، ولكن الأكيد أنها، وعلى عكس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لم تسع إلى مساعدته وتعزيز موقفه سياسياً وشعبياً.
وكانت إسرائيل قد خاضت ثلاثة انتخابات تشريعية غير حاسمة خلال فترة إدارة ترامب، بدءاً من أبريل / نيسان 2019، مروراً بسبتمبر / أيلول من العام نفسه، ثمَّ في مارس / آذار 2020. وفي كل مرة، حصل نتنياهو على دعم سخيٍّ من ترامب الذي افتتح عهده بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر / كانون الأول 2017. ثمَّ قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في سبتمبر/ أيلول 2018. ووقف كل المساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين، في فبراير/ شباط 2019. وبعد ذلك اعترف بضم إسرائيل للجولان، في شهر أبريل/ نيسان 2019. ثمَّ تراجع إدارته، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، عن الرأي القانوني الذي كانت تتبناه الولايات المتحدة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، القائل إن بناء إسرائيل “مستوطنات مدنية” في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”. وصولاً، إلى إعلان ما تعرف بـ”صفقة القرن”، في يناير/ كانون الثاني 2020، والاعتراف بـ”حق” إسرائيل بضم 30% من الضفة الغربية المحتلة. وختم ترامب ذلك كله بالإشراف والدفع بموجة جديدة وواسعة من التطبيع العربي مع الدولة العبرية، كما في حالات الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
كانت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة، في مارس / آذار الماضي، غير حاسمة أيضاً، ولكنها جرت وبايدن في البيت الأبيض. على غير ما اعتاده نتنياهو في المرّات الثلاث السابقة. لم تكن هناك هدايا أميركية مجانية هذه المرة، بل لم يبادر بايدن إلى الاتصال به إلا بعد مضيِّ شهر، تقريباً، من تسلمه الرئاسة. على المستوى الشخصي، فإن علاقة بايدن ونتنياهو قوية وقديمة. وعلى المستوى السياسي، بايدن منحاز بشكل مطلق لإسرائيل، وهو كان وصف نفسه، عام 2007، بأنه “صهيوني”. تعابير ذلك واضحة وكثيرة منذ أصبح رئيساً. يكفي التذكير هنا بالتزامه بقرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والإبقاء على السفارة الأميركية فيها، غير أن في العلاقة بين بايدن – نتنياهو شوائب كثيرة أيضاً. هو لم ينس له إفشاله جهود إدارة باراك أوباما التي كان فيها بايدن نائباً للرئيس، لإنجاز تسويةٍ مع الفلسطينيين. كما أن بايدن لم ينس كيف تحالف نتنياهو مع الجمهوريين، عام 2015، في محاولةٍ لتعطيل الاتفاق النووي مع إيران. والأهم، أن بايدن، كما الديمقراطيين، نظروا بعين السخط إلى التماهي التام بين ترامب – نتنياهو، في الوقت الذي كان فيه الأول يتهمهم بأنهم تحوّلوا إلى محضن لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل.
تضاعف استياء بايدن من نتنياهو جرّاء محاولاته عرقلة جهود إدارته العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي كانت إدارة ترامب خرجت منه عام 2018. جاء بايدن بأولوياتٍ مختلفةٍ إلى البيت الأبيض. داخلياً، تعاني الولايات المتحدة انقساماً مجتمعياً وسياسياً حادّاً بعد أربع سنوات من حكم ترامب. كما أنها لا زالت تعاني من وطأة جائحة كورونا وتداعياتها اقتصادياً، والذي يحاول بايدن إعادة إطلاقه. وعلى صعيد السياسة الخارجية، لواشنطن أولويتان كبريان اليوم: احتواء الصين الصاعدة، قوة اقتصادية وعسكرية عالمية. والتصدّي لمحاولات روسيا إعادة فرضها نفسها على الخريطة الدولية. هذان هما أهمُّ تَحَدِّيَيْنِ جيوسياسيين يواجهان الولايات المتحدة. لذلك هي تريد الانسحاب من أفغانستان، والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإنهاء حرب اليمن وذلك كي تتفرّغ لهما. وآخر شيء كانت تريده إدارة بايدن هو العودة إلى الشرق الأوسط الذي لا يشكل أولوية لديها، بما ذلك ملف التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لكن، وبغض النظر عن مقاربات واشنطن للشرق الأوسط، إسرائيل قادرة دائماً على إفسادها، وبالتالي إفساد بعض مقارباتها الإستراتيجية الأوسع المرتبطة بها. هذا ما جرى تحديداً في التصعيد الإسرائيلي على مدى الأشهر الماضية في القدس المحتلة، وتحديداً في حيِّ الشيخ جرّاح، ثمَّ الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى مطلع الشهر الماضي (مايو/ أيار)، وصولاً إلى شنِّ عدوانها الوحشيِّ أخيرا على قطاع غزّة. صحيح أن بايدن دعم ما سماه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وصحيحٌ أن إدارته أجازت، في خضم العدوان على الفلسطينيين، أسلحة لها بقيمة 735 مليون دولار، إلا أنه هو من أرغم نتنياهو، في نهاية المطاف، على إيقاف الحرب.
لذلك، اتفاق زعيمي حزب “يوجد مستقبل”، يائير ليبيد، وحزب “يمينا”، نفتالي بينت، مع خمسة أحزاب أخرى، على تشكيل حكومة ائتلافية، بهدف التخلص من نتنياهو، كان بمثابة هدية لإدارة بايدن. وهذا لا يعني أن بينت، الذي سيتولى رئاسة الوزراء في العامين الأولين، إن سارت الأمور كما ينبغي، أقلّ تطرّفاً من نتنياهو. على العكس من ذلك، هو على يمينه، سواء في ما يتعلق بالاستيطان والتسوية مع الفلسطينيين، أم في الموقف من الملف النووي الإيراني. إلا أن الجديد هنا أن هذه الحكومة الائتلافية، إن رأت النور، ستكون رهينة تناقضات أطرافها المختلفة. هناك اليمين، مثل حزب “أمل جديد” بزعامة جدعون ساعر، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، فضلاً عن أحزاب دينية واستيطانية. وهناك أيضاً الوسط، كحزب “يوجد مستقبل”، واليسار، كحزبي العمل وميرتس. وهم جميعهم بحاجةٍ إلى دعم القائمة العربية الموحدة، برئاسة النائب منصور عباس، بغض النظر عن مشروعية موقفه هنا. وهذا سيعقّد من جهود بينت لو أراد الاصطدام مع إدارة بايدن بشأن الملف النووي الإيراني، أو حتى التوسع الاستيطاني الواسع في الضفة الغربية. تأمل واشنطن أن يساهم وجود ليبيد المفترض على رأس وزارة الخارجية، في العامين المقبلين، في إعادة العلاقات الأميركية – الإسرائيلية إلى سكّتها المؤسسية بين دولتين، كما كانت عليها قبل حقبة ترامب – نتنياهو. كما تأمل مؤسسة الحزب الديمقراطي التقليدية في أن يساهم ليبيد، سواء وزيرا للخارجية، أم بعد عامين، رئيسا مفترضا للوزراء، بدعم من اليسار الإسرائيلي، في إعادة الحميمية إلى العلاقات المشتركة التي تضرّرت كثيراً في سنوات حكم نتنياهو منذ عام 2009. منذ ذلك الحين، تصاعد نفوذ التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الناقد لإسرائيل، في مقابل تصاعد تأثير التيار الإنجيلي في الحزب الجمهوري، المتحالف عضوياً معها.
باختصار، تتطلع إدارة بايدن إلى فسحةٍ زمانية ومكانية، ولو مؤقتة، في علاقاتها مع إسرائيل، للتفرّغ لأولوياتها الأخرى الأكثر ضغطاً، غير أن هذا ليس بالأمر المضمون. لا زال نتنياهو، على الأقل إلى الآن، يتزعم أكبر كتلة برلمانية، هي الليكود، ولو كان في موقع المعارضة، اللهم أن ينتهي به الأمر في السجن بتهم الرشوة والفساد وخيانة الأمانة. ولا زالت حظوظ استمرار الائتلاف الحكومي الجديد، إن كتب له النجاح، محلّ شك. وفي كل الأحوال، مجرّد توسل الولايات المتحدة تغييراً داخلياً في إسرائيل للتمكّن من السيطرة على جموحها، أو الحدِّ منه، مؤشّر على الخلل في العلاقة بين الطرفين. الأصل أن الدولة العبرية هي من تعتمد في وجودها على أميركا، ولكنها كثيراً ما تتصرّف وكأنها هي من يملك القرار في واشنطن عندما يتعلق الأمر بكثير من ملفات الشرق الأوسط.
———————–
هكذا يتبدل الوعي الاميركي لقضية فلسطين/ لوري كينغ
في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، صدحَ صوت صفارات إنذار الشرطة من أمام منزلي بشكل متواصل على مدى 72 ساعة. اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات في كل أنحاء أميركا، في مدن كبيرة وصغيرة، وذلك عقب مقتل جورج فلويد في 25 أيار/مايو، على يد ضابط شرطة عنصري في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. أسقط المعتصمون تماثيل جنرالات الكونفدرالية التابعة لحقبة الحرب الأهلية الأميركية (1860-1864)، بالإضافة الى تمثال كريستوفر كولومبوس، في حركة تخريبية عمّت البلاد. طالب المعتصمون في الشارع، كما الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بمحاسبة علنية لأميركا حول خطايا عديدة أهمها: الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية واختطاف واستعباد الأفارقة.
في واشنطن، اقتحم عدد من اللصوص “المغامرين” المتاجر الكبرى في جادة ويسكونسن، بينما كان تركيز عناصر الشرطة على مظاهرات Black Lives Matter في وسط المدينة. من جهة أخرى، استغل آخرون الوضع لإلقاء الحجارة والطوب عبر نوافذ المتاجر في نواح عديدة من المدينة، علماً أن “فورة النهب” المخيفة لم تكن مرتبطة بالاحتجاجات السياسية.
على الرغم من وباء كورونا والمطالبة بالتقيد بالإجراءات الوقائية، كالمحافظة على المسافة المجتمعية، إلا أن آلاف الأشخاص، من جميع الأعمار والأعراق والأجناس والطبقات الإجتماعية، اجتمعوا في شوارع واشنطن مرددين هتافات للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد. “حياة السود مهمة”.. هي صرخة يتردد صداها بقوة خاصة في العاصمة، التي يتحدر نصف سكانها أميركيين من أصل أفريقي وهم مستضعفون اقتصادياً.
نظراً لتكرار جرائم قتل عناصر الشرطة للأشخاص من ذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة، تحولت الاحتجاجات الى ظاهرة روتينية، خاصة بعد ظهور حركة Black Lives Matter عقب مقتل مايكل براون في فيرغسون بولاية ميسوري في عام 2014. ولكن في حزيران\يونيو 2020، حصل شيء مختلف: المظاهرات التي أعقبت مقتل أميركيين أفارقة أو أميركيين من أصول أفريقية آخرين على أيدي عناصر الشرطة العنصرية جرت في مواعيد وأماكن معينة. إلا أنه هذه المرة لم تكن هناك من قيود زمنية أو مكانية. إذ تحولت الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض إلى “ميدان عام” يواجه فيه المحتجون، بمختلف أعمارهم وخلفياتهم، على مدى أيام، عناصر من الشرطة مدججة بالسلاح- ومعظمهم من البيض- ومجهزين على هيئة “نينجا”، من معدات وأقنعة سوداء وغيرها.
من جهته، قام الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وفريقه ببذل كل جهوده آنذاك لتصوير المتظاهرين على أنهم متطرفون خطيرون ينتمون الى حركة “أنتيفا”(المناهضة للفاشية) ويخططون للعنف والفوضى والتدمير. لأول مرة منذ عقود، تم إطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين وتم دفعهم بعيداً عن حديقة لافاييت القريبة من البيت الأبيض. وعلى الرغم من ذلك، إستفاضت موجة الغضب والتضامن مع جورج فلويد والأميركيين من أصول أفريقية وانتشرت خارج الولايات المتحدة، حيث شهدت المملكة المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية احتجاجات عديدة في هذا الشأن. قال النقاد: “شيٌ ما تغيّر”. وردد النشطاء “جورج فلويد غيّر العالم”.
مرّ عام، وعلى الرغم من عدم سماع صفارات إنذار الشرطة من خارج نافذتي هذا الأسبوع، حصلت احتجاجات حاشدة في العاصمة واشنطن، وأماكن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأيضاً وأيضاً، في جميع أنحاء العالم. الهدف الرئيسي من تلك الإحتجاجات هو دعم حقوق الفلسطينيين وإدانة تفلت إسرائيل من العقاب على جرائم حرب متتالية في غزة. بدوري، لقد شاركت في ما لا يقل عن ست تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن على مدى العقديْن الماضييْن. عادة، تنطلق التظاهرات من البيت الأبيض ومن ثم يسير المتظاهرون بضعة أميال في المدينة لمدة ساعتين تقريباً. يشارك في تلك التظاهرات نحو ألف شخص، أغلبهم من العرب الأميركيين، وفلسطينيون، ومسلمون، وناشطون من مجموعات السلام. المختلف في هذا العام تحديداً، هو العدد الكبير والضخم للاحتجاجات التي حصلت خلال الأسبوعيْن الماضييْن في واشنطن وأماكن أخرى، وقد جذبت هذه الاحتجاجات أعداداً ضخمة من الناس إلى الشوارع، ومن خلفيات متعددة. وبشكل غير مسبوق، تمحورت عناوين الصحف الأميركية حول قضية فلسطين، إذ لفتت الصحف الانظار الى الانتهاكات الإسرائيلية ونقلت معاناة الفلسطينيين. وأكثر ما كان لافتاً، هو تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نُشر في أواخر نيسان/أبريل، وقد وصف إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري” مما أدى إلى إحداث خرق كبير في ما يقال السردية الدبلوماسية العامة في إسرائيل (hasbara) وحول اعتبار إسرائيل “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
اكتشف الأميركيون فجأة أن حياة الفلسطينيين مهمة، وأن كل التبريرات الإسرائيلية السابقة عن الإبادة الجماعية للمدنيين، والاحتلال، والحصار الاقتصادي، واستيطان أراضِ، وتدمير البنية التحتية، هي جميعها حجج فارغة. وأكثر من ذلك، أصبح من الممكن أن يتحول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة “غير المشروط” لإسرائيل- الى مواضيع رئيسية في السياسة الداخلية الأميركية والنقاشات الانتخابية، وهذا الإتجاه لم يسبق أن حصل منذ الانتفاضة الفلسطينية 1987-1993. وفي حال حصل هذا التوجه، قد يرغب الرئيس الاميركي جو بايدن في إعادة النظر في استراتيجيته (أو بالاحرى في لااستراتيجيته) في التعامل مع التعنت الإسرائيلي وانتهاكات القانون الدولي.
منذ توليه منصبه قبل أقل من خمسة أشهر، وفي أعقاب محاولة “الانقلاب الجمهوري” لمجموعة من المتعصبين البيض في مبنى الكابيتول، حصل بايدن على دعم كبير من قبل الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي لإلغاء سياسات دونالد ترامب الكارثية حول فيروس كورونا، مما خفف الضغط على العائلات الأميركية، وخاصة العمال وأصحاب الطبقة الوسطى، من أجل المضي في التركيز على “الصفقة الخضراء الجديدة” استجابة للاحتباس الحراري، وعلى خطة فرض ضرائب على أصحاب المليارات. حتى إن أنصار المرشح الرئاسي السابق السيناتور بيرني ساندرز أثنوا على سياسة بايدن المحلية حتى الآن. منذ ذلك الوقت، يحاول الرئيس بايدن قدر المستطاع إبطال الضرر الذي أحدثه دونالد ترامب في سياساته التخريبية حول مواضيع عديدة ومنها: الهجرة، العنصرية الممنهجة، حقوق مجتمع الميم والأهم منها، أنه أعاد الخطاب اللائق والمحترم إلى البيت الأبيض.
بايدن.. هو رجل متقدم في السن عانى الكثير في حياته؛ منذ وفاة زوجته وابنته الرضيعة في حادث سيارة منذ أكثر من 40 عاماً، ووفاة أحد أبنائه مؤخراً بسرطان الدماغ، فيما الإبن الآخر سقط في دوامة الإدمان وتملّكه اليأس. هذا الوضع لبايدن يبعث للتعاطف معه، علماً أن الرئيس الاميركي لا يخشى المخاطرة في السياسة المحلية. من ناحية أخرى، يشير العمر المتقدم لبايدن الى انه لن يسعى إلى خوض معركة الانتخابات مجدداً، لذا هو غير منشغل في قراراته وتصريحاته، وما إذا كانت ستعجب الناخبين أم لا. يبدو أنه يريد أن يفعل الصواب، ولهذا السبب، يبدو صمته حول أفعال إسرائيل أمر محيّر. وما لا يمكن إنكاره خلال الشهر الماضي، هو الانقسام الحاصل بين بايدن والقاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي.
في آذار/مارس 2010، قام بايدن، وقد كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس الاميركي باراك أوباما، بزيارة رسمية إلى إسرائيل، في محاولة لاستئناف محادثات السلام والمفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد حرصت إدارة أوباما على حل المسألة دبلوماسياً، لكن إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت معارضة لسياسات أوباما، خاصة بعد خطابه الشهير في جامعة القاهرة الذي طرح فيه بداية جديدة مع العالمين العربي والإسلامي. وبعد وقت قصير من وصول بايدن إلى إسرائيل، والإعلان علنياً أنه في ما يتعلق بالامن الإسرائيلي “لا يمكن الفصل بين بلدينا أميركا واسرائيل”، تلقى بايدن، ومعها إدارة أوباما أجمعين، صفعة قوية حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سيتم بناء 1600 وحدة سكنية جديدة لليهود في القدس الشرقية. صرح بايدن وقتها أن هذه كانت “خطوة في اتجاه تقويض الثقة التي نحن في أمس الحاجة إليها الآن”. وقد حثّ وقتها المسؤولون في وزارة الخارجية في واشنطن بايدن على العودة إلى أميركا. لكن بايدن قرر الإستمرار في الزيارة وحضر، وإن متأخراً، عشاءً أقامه نتنياهو على شرفه.
وعلى الرغم من الإذلال الذي تعرض له بايدن من قبل نتنياهو قبل نحو 12 عاماً، إلا أن بايدن لم يتعلم الدرس وما زال المسؤولون الإسرائيليين يعتبرونه “أحمق”. وفي كل الاحوال، سيبقى دونالد ترامب الرئيس الأميركي المفضل لدى اسرائيل، مهما حاول بايدن والحرس القديم للحزب الديمقراطي إثبات ولائهم لإسرائيل في سياساتها الفاشية الحالية، ستودّ إسرائيل دائماً أن ترى ترامب أو أي شخص مماثل له في البيت الأبيض في الانتخابات القادمة في 2024. عدا عن أن قاعدة الدعم الأميركي لليمين المتشدد في إسرائيل متواجدة في الحزب الجمهوري، وخاصة بين المسيحيين الصهاينة الإنجيليين البيض. وبالتالي، لا يمكن لبايدن أن يفوز بأصوات هؤلاء الناخبين عبر منح نتنياهو وجماعته العنصرية الحكم المطلق. هو لا يستطيع أن يتفوق على ترامب من خلال إعطاء إسرائيل كل ما تطلبه.
الإنشقاق الحاصل داخل الحزب الديمقراطي يمهد لمطارحات أيديولوجية مختلفة لأجيال عديدة قادمة. وعلى وجه الخصوص، اليهود الأميركيون الأصغر سناً، الذين برز تواجدهم في عدد من الاحتجاجات الأخيرة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وقبل أسبوعين، أصدر فريق العمل في حملة بايدن (معظمهم ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا) خطاباً مفتوحاً يحثون فيه الرئيس على اتخاذ موقف مختلف تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بدورهم، ينظم الموسيقيون في الوقت الحالي حملة لدعم حقوق الإنسان والفلسطينيين، ما يذكرنا بالاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري التي هزت نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا قبل 30 عاماً. شاء أم أبى، يتم جر بايدن والحزب الديمقراطي إلى نقاش طال انتظاره حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
“حياة الفلسطينيين مهمة”.. هكذا يتبدل الوعي الاميركي تجاه القضية الفلسطينية، حيث لا يمكن تصنيفها ضمن قضايا السياسة الداخلية المحلية أو الخارجية. هذا الأمر أصبح جلياً داخل الكونغرس الأميركي، وكذلك في الجالية اليهودية الأميركية. من جهة أخرى، إن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، المتمثل في النساء الشابات الملونات، وهم: ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر وكوري بوش – على خلاف واضح مع الحرس القديم في الحزب الديمقراطي الذي يتشكل معظمه من رجال “من ذوي البشرة البيضاء”، والذي يمثل بايدن أفضل تجسيد لهم.
شيء ما تبدل في الولايات المتحدة خلال العام الماضي: الإطار السردي حول قضية فلسطين. “حياة السود مهمة” كما النشاطات والحملات التي يقوم بها الأميركيون الأصليون في الشوارع، بالإضافة إلى الخطاب الجديد الذي يرتكز على مبدأين وهما إنهاء الاستعمار والتعويضات للفلسطينيين، وهو خطاب يروج له بين المثقفين التقدميين والأكاديميين والمحللين والناشطين، هي جميعها تعيد بلورة تصورات ومفاهيم الأميركيين للفلسطينيين، على سبيل المثال، بأنه يحق للفلسطينيين بالحصول على حقوقهم كسائر البشر. الفلسطينيون وعلى غرار ما حصل لجورج فلويد، يتعرضون للأفعال الوحشية على يد إسرائيل، إلا أن بايدن وفريقه من الحرس القديم في الحزب الديمقراطي يتجاهلون الخطاب المتغير في ما يخص القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة.
————————–
رواج الموسيقى العربية يقلق إسرائيل: تهديد لـ”الدولة اليهودية”/ أدهم مناصرة
كان لافتاً أن تُغيّر صحيفة “هآرتس” اليسارية، في عنوان مقال نشرته، كلمة “تهديد” إلى “انتصار” ليصبح (أحدث انتصار لـ”تيك توك”: تحويل الاسرائيليين إلى عشاق الموسيقى العربية).. فلم يُعرف إن كانت الكلمة الأولى قبل تغييرها كُتبت على سبيل السهو أم تعبيراً عن اللاوعي لكاتبة المقال خين المالي ومهندسي التحرير! بمعنى آخر: هل اعتبرت تعلق الشباب الاسرائيلي الجديد بالموسيقى العربية، ايجابياً، أم تهديداً لهوية “الدولة اليهودية” التي يسعى الاحتلال تكريسها على أرض فلسطين؟
تُقر الصحيفة أنه بفعل الحدود المفتوحة لوسائل التواصل الاجتماعي يستمع عدد متزايد من الشباب اليهود “الإسرائيليين” إلى الموسيقى العربية – “مثلما اعتاد أجدادهم أن يفعلوا ذلك”، على حد تعبيرها. وتلجأ إلى أسلوب الحكاية، “أبطالُها” مجموعة من الشباب الذين وصفتهم بـ”المراهقين المتمردين” يمارسون رياضتهم على دراجات هوائية في حديقة بمنطقة ما في دولة الاحتلال معظم سكانها يهود، لكنهم يكسرون هدوء المكان، عبر صخب موسيقى عربية، لا عبرية.. هي حديثة ليست تقليدية أو كلاسيكية معروفة سلفاً.
ورغم محاولة الكاتبة أن تتحدث بإيجابية عن ذلك من خلال اعتبار الواقعة “صحوة جديدة، خصوصاً بين جيل الشباب الاسرائيلي الذي يريد إعادة الاتصال بالعالم العربي”، على حد قولها، إلا أنها اخفت ضمنياً عنصرية وفوقية حين تتبعت ردود أفعال الاسرائيليين “المندهشين” إزاء الموسيقى العربية التي علت في المكان.. واصفة إياها بـ”الصاخبة” و”غير العادية” و”انها لا تشبه اي شيء سمعه الإسرائيليون من قبل”.
لم تكن الكاتبة صريحة بما يكفي كي تعترف بأن أحد دوافع محاولات الإسرائيليين معرفة اللغة العربية من بوابة الموسيقى والاغاني، مرتبط بالخوف على الذات واستمرارية الاحتلال، من منطلق “التعرف على العدوّ العربي” جيّداً وكيف يفكر! ويتجلّى هنا ما يدفع تل أبيب إلى تكريس طغيان ثقافتها العبرية على أجيالها المتعاقبة، حيث تقول كاتبة المقال: “هذا هو السبب في أن فرقة المراهقين فاجأت الجميع بالأغاني العربية التي بثتها عبر مكبرات الصوت، كما لو أن هذا ليس المكان الطبيعي لهذه الموسيقى، أو على الأقل ليس المكان الذي تتوقع أن تقابله فيه”. فحتى سنوات قليلة ماضية، كانت الموسيقى العربية بشكل عام، والشعبية خصوصاً، تُسمع فقط في أماكن محددة، الحفلات والمناسبات العائلية والنوادي الليلية والبارات في تل أبيب، كما تقول الكاتبة. “لكنها الآن في كل مكان. حقاً في كل مكان”.
لعلّ الدافع الأبرز لنشر هذا المقال في “هآرتس” هو شعبية الموسيقى العربية لدى الشباب اليهودي الاسرائيلي، وهي في تزايد مستمر، إذ أن سماعها لم يعد يقتصر على حفلة الحنّاء أو الزفاف خصوصاً لدى اليهود من الأصول العربية، بل بات يُسمع في كل مكان ووقت. وهنا يتساءل المقال: “كيف ولماذا؟”.. ثم يستدرك: “الإجابة هي نفسها كما هو الحال مع أي محاولة لفهم ظاهرة ثقافية حالية؛ بسبب تطبيق تيك توك”.
هنا، تتحدث الكاتبة الاسرائيلية البالغة من العمر سبعة وثلاثين عاماً، عن تجربتها مع “تيك توك”، حيث تقول إنه أخيراً، ورغم انها ليست مستخدمة نشيطة في التطبيق، قفز أمامها مقطع فيديو لنجم البوب الاسرائيلي ايدن بن زاكين، وهو يرقص على ريمكس شعبي على التطبيق الرقمي. وهو مزيج من أغنية “Let’s Link” لمغني الراب الأميركي WhoHeem والآخر هو “شكلي حبيتِك” لنجم الإنترنت اللبناني حمادة نشواتي. وهذا المثال، بالنسبة للكاتبة، شكل مزيجاً موسيقياً بصرياً، يلخص تماماً أزمة لدى الشاب اليهودي الاسرائيلي الذي وجد نفسه في محور ثقافي بين أميركا والشرق الأوسط.. بين العربية والإنكليزية، بين انفجار موسيقى الهيب هوب وحدث عربي.
ومع كل التفاؤل الذي يحيط بالاختراق الثقافي، تعود “هآرتس” وتُقرّ بأن “تيك توك” بمثابة خليط من مقاطع الفيديو لما وصفته “العنف اليهودي- العربي” لا سيما في ضوء القتال في قطاع غزة والاضطرابات الداخلية في المدن المختلطة داخل أراضي 48 الفلسطينية. بيدَ أن الكاتبة حاولت ان تخفف مخاوف الإسرائليين من غزو الموسيقى العربية وسطوع شعبيتها لدى الجيل اليهودي المراهق، عبر ضرب امثلة تظهر أن الهوية الثقافية العربية “لا تنتقص من الهوية اليهودية الدينية”، وبالتالي يمكن للمرء أن يستنتج أن الصراع يجب أن يقتصر على “أبعاده الوطنية”، حسب تعبيرها.
الواقع أنّ الإشكالية الدائمة تكمن في دعاية الاحتلال التي تزج باليهود وكأنهم مشكلة الفلسطينيين والعرب، في حين أن مشكلة الأخيرين هي مع الحركة الصهيونية التي استغلت اليهودية لتسويغ احتلال الغرباء من أنحاء العالم لأرض ليست لهم. وهنا، تقع الكاتبة الاسرائيلية في مربّع الدعاية نفسه، رغم تسويق نفسها كشابة منفتحة على الثقافة العربية وتتبنى نهجاً يسارياً.. إذ أنها تتحدث بطريقة وكأن اليهود هم طرف الصراع مع الفلسطينيين، والحقيقة هي قضية شعب مع مُحتلّه. وبينما تتحدث هذه الشابة الاسرائيلية عن الماضي الذي امتلأ بالتشاركية بين اليهود والمسلمين والمسيحيين على هذه الأرض، تقع في خطيئة أخرى عبر تمييزها للغة والهوية العربية في الماضي مقارنة مع الحاضر. فحسب وصفها، كانت هذه اللغة “مُحايدة”. وكأنها تريد ان تقول إنها “لم تعد كذلك الآن، حتى قرروا رسم حدود حولنا”.
ويُبدي المقال اندهاشه من أن نرى كيف، عبر “تيك توك” و”انستغرام” و”يوتيوب”، وبسبب العولمة المتزايدة وإمكانية الوصول، تمر اللغة العربية بعملية تصبح مرة أخرى “محايدة” بالموسيقى.. لكن، يُستشفّ من خاتمة المقال، تحذير إسرائيلي “دعائي” من “العربية السياسية” في مقابل ترغيب في “العربية الغنائية”!
المدن
————————–
محمد ومنى الكرد : جيل الألفية الثانية إذ يستعيد القضية الفلسطينية
ترجمة – هآرتس
محمد الكرد ومنى الكرد صارا المصدر الأول لوسائل الإعلام التي تسعى إلى الاستماع إلى أصوات من حي الشيخ جرّاح. ساهم هذا الحضور الفعال في تشكيل السردية والرواية المتداولة حول الحي الذي أصبح له رمزية للحق الفلسطيني.
بينما كانت إسرائيلُ تشن على غزة غاراتها الجوية لأحد عشر يوماً، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 أيار/ مايو، غابت السلطة الفلسطينية عن المشهد بشكل مخيف، فلم تفعل أكثر من إصدار تصريحات شكلية تدين حملة القصف الإسرائيلية وما نتج عنها من عدد مذهل من القتلى.
لكن على أرض الواقع، شغلَ القادة المدنيون، بخاصة الشباب الفلسطيني، الفراغَ الذي تركته تلك القيادة التائهة. فقد نظّم الشباب مع مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني إضراباً عاماً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل. كان الإضراب مهماً لالتزام جانبَي الخط الأخضر به بشكل صارم، وهو ما محا تماماً، وإن بشكل موقت، الانقسامَ الجغرافي والسياسي المتغلغل بين الفلسطينيين من مواطني إسرائيل.
كان إحباط الفلسطينيين تجاه قيادتهم، قبل هذه الأزمة، قد بلغ بالفعل مستويات غير مسبوقة. ولطالما كانت فرصة وجود ديموقراطية فلسطينية أمراً محدوداً، نتيجة تحكُّم إسرائيل في جميع أوجه الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النظام الانتخابي. ففي الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، عام 2006، عرقلت إسرائيل بشدة الاقتراع في القدس الشرقية. وعندما حظيت “حركة حماس” بفوز حاسم، زعزعت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل استقرار الحكومة الجديدة، وولت رئيسَ السلطة الفلسطينية محمد عباس وحزبَه، “حركة فتح”، مقاليدَ الحكم في الضفة الغربية.
في كانون الثاني/ يناير، دعا عباس إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية هذا الربيع والصيف، ولكن لم يفاجأ كثيرون حين أجَّلها أخيراً في 29 نيسان/ أبريل، لأجل غير مسمى. ومع أن عباس عَزَا قراره إلى رفض السلطات الإسرائيلية السماح بالتصويت في القدس الشرقية، يعتقد كثيرون أن هذا القرار في الحقيقة استجابة لانشقاق داخل “فتح”، يهدد بتعقيد إعادة انتخابه وإضعاف قبضته الحديدية على مؤسسات السلطة الفلسطينية.
لعل الانتخابات منحت الناخبين الفلسطينيين الفرصة لتقديم دعمهم لقوائم انتخابية مستقلة. ومع أن قيوداً قانونية قمعية منعت بعض المجموعات من الترشح -مثل “جيل التجديد الديموقراطي”، وهي مبادرة سياسية شبابية- أظهرت استطلاعات الرأي العام دعماً متزايداً لقائمة جديدة بقيادة ناصر القدوة، ابن أخ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي قامت حملته على وعد بمحاربة الفساد المتفشي، ودعم حكم القانون، وإقامة انتخابات بشكل منتظم.
ساهم تأجيل الانتخابات في زيادة خيبة الأمل بين الفلسطينيين، الذين سجلوا بعدد كبير للتصويت، على رغم استطلاعات الرأي التي تظهر شكوكاً عميقة حول حرية ونزاهة أي انتخابات تقام تحت الظروف الحالية. إذ يرى كثر من الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية تمنعهم من اختيار ممثليهم الذين يعبرون عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
مثلت الانتخابات الجديدة فرصة نادرة للشبان الفلسطينيين على وجه الخصوص. فقد ظل عباس، الذي يبلغ من العمر 85 سنة، يتولّى منصب الرئيس منذ انتخابه عام 2005. وكان يفترض ألا تتجاوز فترة رئاسته أربع سنوات. ولم يُدلِ الكثير من الشباب الفلسطينيين الذين ولدوا بعد معاهدة أوسلو التي وُقعت عام 1993 بصوتهم أبداً. بينما اختارت الولايات المتحدة تجاهل هذا المفارقة التي تتناقض بشكل صارخ مع القيم الأميركية المزعومة حول حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية.
تقول نادية حجاب، شريك مؤسس ورئيسة “الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية”، إن “إلغاء الانتخابات ضاعَفَ مشاعرَ الإحباط والغضب”، وأردفت أن “أي انتخابات تحت الاحتلال ليست ذات معنى، لأنك فعلياً لا تملك أي سلطة على الإطلاق”؛ إلا أنها أكدت أن خسارة الفرصة للانتخاب تظل مثبِطة للهمم.
قبل فترة قصيرة من إصدار عباس مَرسومَه، كانت الاحتجاجات في القدس قد بدأت بالفعل تجتذب الاهتمام الدولي، وذلك عندما أقامت السلطات الإسرائيلية حواجز عند “باب العمود”، الذي يعد ساحة التجمع الرئيسية لكثير من الفلسطينيين، لا سيما الشباب منهم، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك، بزعم أن الجلوس في المنطقة محظور منذ ما يزيد على العقد.
على مسافة ليست ببعيدة، في حي الشيخ جراح، كانت عائلات فلسطينية تحتج على احتمال طردها من بيوتها على يد جمعيات استيطانية إسرائيلية يمينية. وتزايدت التظاهرات بعدما أصدرت محكمة ابتدائية إسرائيلية في القدس حكماً لمصلحة المستوطنين في وقت سابق من هذا العام. وفي 9 أيار/ مايو، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها سوف ترجئ النظر في قرار الإخلاء لموعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.
في خضم هذا المشهد، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين في ليلة القدر -أعظم ليالي رمضان- ليتفجر الوضع في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأرجاء إسرائيل. وبدأت الصواريخ التي تطلقها “حماس” من قطاع غزة المحاصر تمطر سماء إسرائيل، لتتبع ذلك هجمات جوية عنيفة شنتها القوات الإسرائيلية على القطاع، ما أدى إلى مقتل 248 فلسطينياً و12 إسرائيلياً.
إضافة إلى الدمار والخوف، أحدثت الأزمات التي شهدتها غزة والقدس الشرقية مستويات جديدة من الوحدة في صفوف الكيان السياسي الفلسطيني، الذي ظل لفترة طويلة يعاني من الانقسام. فقد خلَّف الشقاقُ السياسي بين حركة “فتح”، التي تدير الضفة الغربية، وبين حركة “حماس”، التي تسيطر على غزة، انقساماتٍ سياسيةً وجغرافيةً بين الفلسطينيين لأكثر من عقد.
فقد تُركت القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وظلت تفرض سيطرتها عليها منذ ذلك الحين، من دون تمثيل سياسي إلى حدٍّ كبير، وبقِيَت غزة معزولة عن العالم بسبب الحصار المفروض عليها منذ 2007، بينما عَلِق المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في محاولة إيجاد مَن يمثّلهم من الأحزاب العربية التقليدية والمشاركة في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يرفض مساواتهم ببقية المواطنين.
لكن أخيراً أثبت الفلسطينيون على كلا جانبَي الخط الأخضر أنهم كيان واحد. فقد وحدتهم قضية حي الشيخ جراح، التي أصبحت رمزاً لنضالهم المشترك الذي يتجاوز الخلافات التقليدية بين الفصائل ويُترجَم إلى فعل حقيقي على أرض الواقع.
من دون بيانٍ سياسي عليهم الالتزام به، انتقل الشباب الفلسطينيون إلى منصات التواصل الاجتماعي واتخذوها منبراً لزيادة الوعي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات التهجير التي تلوح في الأفق لأبناء شعبهم في القدس الشرقية.
ومع حرمانهم المشاركة الرسمية في الانتخابات الفلسطينية وتعرّضهم للقمع على يد قوات الأمن الإسرائيلية -بل والفلسطينية في بعض الأحيان- ما زال أولئك الشباب الفلسطينيون ينظمون حملات على أرض الواقع، ويشكلون مجموعات دعمٍ في أماكنٍ مثل حي الشيخ جراح، ويحضرون جلسات المحاكم الإسرائيلية، ويوصلون أصواتهم من خلال الاحتجاجات والتحدث إلى وسائل الإعلام. نجح هذا التضافر الجماعي لأولئك النشطاء، من دون أي تنسيق مسبق، في إعادة استحواذ القضية الفلسطينية على التيار السياسي الرئيسي.
وقال المؤرخ والأستاذ في جامعة كولومبيا، رشيد الخالدي، “فشل أولئك الأشخاص الذين يدعون أنهم قادة الشعب الفلسطيني في إعداد خطة وطنية. لهذا فإن المجتمع المدني الفلسطيني هو الذي يتولى القيادة الفلسطينية حالياً”.
ضمَّت التظاهرات قوة شبابية مميزة في القدس الشرقية -الخاضعة لسيطرة إسرائيل- حيث لا تملك السلطة الفلسطينية أيّ إمكانية أو سلطة سياسية لكبح جماحهم. وبالنسبة إلى الفلسطينيين هنا في القدس، تميز العقد الأخير بتزايد التهميش الذي يتعرضون له. فقد زادت معدلات الفقر والجريمة بدرجة كبيرة للغاية، ما أدى إلى زيادة السخط وتفشي المخدرات وارتفاع نبرة الغضب التي يمكن سماعها في أغاني “الراب” العدمية التي تُصاغ كلماتها خلف الجدار الفاصل في بلدات كالعيسويّة وكفر عقب ومخيمات اللاجئين المتداعية في قلنديا وشعفاط.
يعيش الشباب الفلسطينيون في القدس الشرقية حياة مختلفة للغاية عن أقرانهم في الضفة الغربية المحتلة أو في غزة، إذ يتمتعون بحرية التنقل والحق في العمل داخل إسرائيل. لكن في الوقت ذاته، لم يتم استيعابهم في المجتمع الإسرائيلي إلى حدٍّ كبير.
ومع أن الفلسطينيين المقدسيين يستخدمون اللغة العبرية العامية، بل وحتى يلتزمون أحياناً بالأعراف الاجتماعية الإسرائيلية، فإنهم يواجهون تهميشاً رسمياً في القوانين، سواء على مستوى الدولة أو مستوى البلديات.
فقد أقرَّت إسرائيل، على مدى السنوات، طائفة من السياسات التمييزية في أنظمتها القضائية العسكرية والمدنية، التي قيّدت إمكانية حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء، وجعلتهم في الوقت ذاته عرضة لعمليات نزع ملكية الأراضي والفصل الأسَري على يد الدولة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.
تأتي هذه السياسات في إطار محاولات إسرائيل الرامية إلى تهويد القدس وخلق أغلبية يهودية في المدينة؛ وهو الأمر الذي يعد من نواحي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النهج الذي تتبناه في المناطق الشاسعة التي تحكمها ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
للمفارقة، فإنّ غياب السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، الذي مثّل لفترة طويلة سبباً من أسباب عزلتها السياسية، صار اليوم يمثّل فرصة لتشكُّل حركة شعبية بل وحشد الدعم الدولي للعائلات المهدَّدة بالإخلاء والتهجير في حي الشيخ جرّاح. وفي الضفة الغربية، حيث أبدت السلطة الفلسطينية التزاماً صارماً باتفاقية التنسيق الأمني مع إسرائيل، غالباً ما تُرسَل قوات الأمن الفلسطينية إلى مواقع الاحتجاجات، حيث تقوم بقمع التظاهرات أو احتجاز الفلسطينيين بأوامر من السلطات الإسرائيلية. وقد شهدنا حادثاً من هذا النوع في مدينة الخليل.
إضافة إلى ذلك، تعكس الطريقةُ التي أبدَى بها الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر دعمهم الاحتجاجات في القدس الشرقية، تغييراً في الإجماع السياسي الفلسطيني.
وقال يوسف مُنيِّر، الكاتب والمحلل السياسي الأميركي -الفلسطيني المقيم في واشنطن، إن التحركات السياسية السابقة، مثل الانتفاضتَين، أتت “في لحظة تم فيها تأطير القدرات السياسية والمحور السياسي الفلسطيني ضمن جهود إقامة دولة، وداخل إطار حل الدولتين. أما اليوم فقد اختفى هذا الإجماع؛ وصحا الناس على واقع أننا نعيش في نظام فصل عنصري يقوم على أساس دولة واحدة”.
أدت هذه اليقظة إلى إحداث تعبئة جماهيرية على نطاق ومدى غير مسبوقَين. فالناس الذين بدأوا التظاهرات ضد محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جرّاح انتقلوا للاحتجاج ضد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة ونظام القمع القائم ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أعمال العنف الطائفي في المدن المختلطة. ومع أن أعمال الشغب كانت من الاتجاهين، إلا أن معظم الاعتقالات والتهم -وهي 750 حالة اعتقال و170 تهمة- التي وجهتها الشرطة الإسرائيلية كانت بحق فلسطينيين، بصورة غير متكافئة.
بينما أذعنت المؤسسات الإعلامية العريقة كالمعتاد للروايات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، يقدِّم اليوم الشبابُ الفلسطيني على “تيك توك” و”إنستاغرام” و”واتساب”، وغيرها من التطبيقات الأخرى، روايةً بديلة- من خلال التغطية المباشرة للأحداث ونشر الصور والميمات ومشاركتها عبر هواتفهم المحمولة. قدمت هذه التقنيات وسيلةً فعالة لحشد التضامن من الأصوات المتفرقة في جميع أنحاء الشتات، سواء عبر الإنترنت أو في الشوارع — فقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً رائداً في تعبئة المحتجّين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم. وقد تبادل أيضاً مؤيدو القضية الفلسطينية النصائح حول كيفية التغلب على الرقابة التي وضعتها منصات التواصل الاجتماعي.
“أنا مندهشة من هذا الدعم [في أوساط الفلسطينيين] من الضفة الغربية وفي المدن الإسرائيلية نفسها وفي قطاع غزة. يمكننا أن نرى رسائل التضامن بين أشخاص لا يمكنهم حتى الالتقاء مع بعضهم بعضاً”، تقول إيناس عبد الرازق، مديرة حملات المناصرة في معهد فلسطين للديبلوماسية العامة في رام الله.
في 8 أيار، منعت الشرطة الإسرائيلية الكثير من الحافلات التي تُقلّ فلسطينيين، آتين من المدن الإسرائيلية، من دخول القدس. ولهذا قرر الفلسطينيون مواصلة الطريق سيراً على الأقدام. حين بدأت صور وفيديوهات ملتقطة عبر الهواتف تصل إلى منصات التواصل الاجتماعي، قام الكثير من المقدسيين بقيادة سياراتهم الخاصة لاستقبال هؤلاء الوافدين سيراً على الأقدام.
يؤمن بعض الفلسطينيين أنه آجلاً أم عاجلاً ستظهر قيادة جديدة من خارج سماسرة دوائر النفوذ والأحزاب السياسية الفلسطينية التقليدية.
“لقد فشل هذا الجيل الذي يدير الأمور، وعليه ترك الساحة (لغيره). وإلى أن يحدث هذا، فإن ذلك الفراغ سيملأه حتماً أناس مثل شباب القدس”، يقول المؤرخ رشيد الخالدي.
محمد ومنى
من هؤلاء الشباب محمد الكرد ومنى الكرد، اللذَان صارا المصدر الأول لوسائل الإعلام التي تسعى إلى الاستماع إلى أصوات من حي الشيخ جرّاح. ساهم هذا الحضور الفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السردية والرواية المتداولة حول الحي الذي أصبح في الفترة الأخيرة منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت منى لمجلة +972 في بدايات شهر أيار الماضي، “الانتفاضات الشبابية هي ما ينقذ هذا المكان. فقضية حي الشيخ جرّاح قضيتهم أيضاً، وبيوتنا بيوتهم؛ وما يحدث هنا لهذه البيوت قد يحدث لبيوتهم في المستقبل”.
مراراً وتكراراً على مدار شهر نيسان الماضي، سواء خلال احتجاجات “باب العامود” أو ما أعقبها من رد فعل جماعي على ما يحصل في حي الشيخ جرّاح ثمّ غزة، حدَّد الفلسطينيون مساحتهم وسرديَّتهم الخاصة، على رغم الجهود الإسرائيلية في نزع الشرعية عنهم. ومع أن اتساع نطاق العدوان الجوي الإسرائيلي على غزة قد طغى في بعض الجوانب على اهتمام وسائل الإعلام في حي الشيخ جراح، فإن من الواضح أن “الحركة الوطنية الفلسطينية” قد اجتازت المرحلة الصعبة وانتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة. فالشباب الفلسطيني يدرك أن لديه القوة والفعالية ومفاتيح المستقبل، حتى وإن كان في ظل الاحتلال أو تحت القصف.
هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
درج
——————————–
=======================
تحديث 08 حزيران 2021
—————————
تسمية الأمور بأسمائها: الابرتهايد الاسرائيلي/ مروان المعشّر
طرح النهج الحقوقي مواز للسياسي لتحقيق شكل الدولة الفلسطينية الذي ترتضيه الأطراف المعنية.
قبل أربعة اعوام، في آذار عام ٢٠١٧، نشرت منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة تقريراً اتهم اسرائيل بممارسة نظام فصل عنصري أو ما يُدعى بالأبرتهايد ضد الفلسطينيين. وبعد نشره بيومين، طالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة رسمياً بسحبه، وتعرضت آنذاك الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل سحب التقرير. اعتبرت الدكتورة خلف ذلك تدخلاً سياسياً في تقرير بحثي، اعتمد على معطيات قانونية أعدها خبراء دوليون مرموقون، وقدمت على إثره استقالتها إلى الأمين العام للمنظمة الأممية.
إن اتهام أي دولة في العالم بتطبيق نظام فصل عنصري أمر في غاية الخطورة لما يترتب عليه من تبعات قانونية وعقوبات دولية تستوجبها القوانين الأممية، كما تقتضيها الاعتبارات الانسانية والحقوقية. ولذلك، من الطبيعي أن تقف الولايات المتحدة، كما العديد من دول العالم وبخاصة الغربية منها، ضد مثل هذا التوصيف لإسرائيل.
ومنذ بداية العملية السلمية في مدريد واعتماد إطار أوسلو كمرجعية للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وجد المجتمع الدولي ذريعة ملائمة لتجاهل، ليس فقط انتهاكات اسرائيل للقوانين الدولية واحتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وانما تطبيقها نظامين قانونيين منفصلين داخل الأراضي التي تسيطر عليها—واحد يطبق على الاسرائيليين اليهود، والآخر يطبق على الفلسطينيين، أولئك الذين تحت الاحتلال الاسرائيلي، كما أولئك الفلسطينيين العرب الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية—و هو التعريف القانوني لنظام الفصل العنصري “الابرتهايد”. وكانت حجة المجتمع الدولي غير المعلنة أن مثل هذه الانتهاكات ستصبح غير ذات معنى متى تحقق حل الدولتين، ونشأت الدولة الفلسطينية المستقلة وأُنجز الانفصال بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن. فبعد حوالى ثلاثين عاماً على إطار أوسلو، أصبح حل الدولتين أقرب الى المستحيل، وتعمّقت الانتهاكات الاسرائيلية، وزاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من مائتين وخمسين ألفاً الى أكثر من سبعمائة ألف مستوطن إسرائيلي، وأقرت اسرائيل قانوناً للقومية اليهودية يجعل سكانها من العرب، مواطنين من الدرجة الثانية قانونياً، وليس فعلياً فحسب. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العديد من المناسبات عدم نيته الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو القبول بإقامه دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، بل عمل بشكل وثيق مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على ضم المزيد من الأراضي المحتلة بغطاء أميركي وقتل حل الدولتين الذي ينادي به المجتمع الدولي.
من جانبه، تشبث جيل أوسلو الفلسطيني بحل الدولتين، لأنه من وجهة نظره يُحقق الدولة الفلسطينية، وينهي الاحتلال الاسرائيلي، ويسمح بتطور المؤسسات الفلسطينية وتطوير الهوية الفلسطينية المستقلة. إلا أن التركيز على شكل الحل من المجتمع الدولي، بدلاً من موضوع الحقوق، أدى الى الوضع الحالي، إذ بات العديد من أبناء وبنات الجيل الجديد الفلسطيني، الذي ولد معظمهم بعد اتفاقية اوسلو، لا يهمهم دولة دون حقوق، بعدما أصبح واضحاً أن الدولة لا تضمن الحقوق إن بقيت شكلاً دون مضمون، لا في فلسطين ولا في غيرها، بينما سيؤدي تحقيق الحقوق الى اقامة دولة ديمقراطية على أسس متينة.
ان كانت الشمس الحقوقية قد تم تغطيتها بغربال سياسي دولي، تشير المعطيات الحالية ان هذا الغربال ما عاد قادرا على منع منظمات حقوقية وبحثية دولية اليوم من الوصول الى استنتاج صارخ بأن ما تقوم به اسرائيل ليس ممارسات فردية أو منعزلة تنتهك حقوق الانسان هنا وهناك، بل هو جزء من منظومة اسرائيلية عنصرية. كما أن هذه الممارسات، من هدم للبيوت واقامة المستوطنات وتشريع مبني على أسس عرقية وادامة الاحتلال لأكثر من نصف قرن وغيرها، هي جزء من نظام فصل عنصري حسب التعريف القانوني لمثل هذا النظام السياسي.
وقد صدرت خلال الأشهر الماضية، تقارير حقوقية وبحثية عديدة من منظمات دولية تقع في صلب المشهد الدولي. فقد نشرت أكبر منظمة اسرائيلية لحقوق الانسان داخل اسرائيل “بيتسيلم”، تقريراً في شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام يقول إن ما تمارسه اسرائيل من سيادة يهودية على الأراضي من النهر الى البحر هو الابرتهايد بعينه. ثم تبع ذلك تقرير مركز كارنيغي في العشرين من شهر نيسان (أبريل) الماضي، وهو من أهم وأحد أعرق مراكز البحث في الولايات المتحدة، يطالب الادارة الاميركية باعتماد مقاربة تعتمد على الحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين، ويصف أيضاً الممارسة الاسرائيلية داخل الأراضي التي تسيطر بأنها تُماثل نظام فصل عنصري. ومؤخراً، صدر تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش” – وهي من أكبر منظمات حقوق الانسان الدولية – لتؤكد هي الأخرى أن اسرائيل تمارس نظام فصل عنصري بكل ما في الكلمة من معنى.
نشهد اليوم بداية تكوين كتلة حرجة، أممية وحقوقية وبحثية، تنعت السياسة الإسرائيلية بالعنصرية. وهي كتلة لم تعد تقتصر على منظمات تُتهم بالتعصب في بعض الأحيان، ولكن من منظمات معروفة دولياً وتتمتع بمصداقية عالية. وفي حين لم يجد هذا التوصيف طريقه بعد للمجال السياسي، فما من شك أن ذلك سيتحقق بوتيرة متزايدة من الآن فصاعداً.
نعيش اليوم في زمن باتت المجتمعات فيه تُولي قدرا أكبر من الاهتمام لموضوع الحقوق المتساوية وعدم جواز الاضطهاد المؤسسي بأي شكل من الاشكال. وما حادثة قتل المواطن الأميركي الأسود فلويد جورج على يد شرطي أبيض في ولاية مينسوتا وما أحدثته من ردود فعل قوية من المجتمعين الأميركي والدولي، إلا دليلاً اضافياً على أن المجتمع الدولي في طريقه لإيلاء موضوع الحقوق أهمية متزايدة.
من هنا تكمن أهمية التركيز على الحقوق الفلسطينية وعلى مقاومة النهج العنصري الاسرائيلي، وذلك بالتوازي مع دفع المسار السياسي لتحقيق الفلسطينيين لتطلعاتهم الوطنية. لا بد من التأكيد هنا أن اعتماد المسار الحقوقي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وهو يتماشى مع أي شكل للحل، سواء كان حلاً معتمداً على أساس الدولتين أو الدولة الواحدة. إنه ببساطة ادراك بأن المسار السياسي الذي لا يرتكز على الحقوق لن يؤدي الى تحقيق تطلعات الفلسطينيين لدولة مستقلة ذات سيادة كاملة، لا يقل وعاؤها الحقوقي والانساني أهمية عن شكلها السياسي.
مركز مالكوم-كير-كارنيغي للشرق الأوسط
————————————
كسر الأمر الواقع بين إسرائيل وفلسطين/ زها حسن, دانيال ليفي, هلا أمال كير, مروان المعشّر
ملخّص:
على النهج الأميركي الجديد أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى.
Related Media and Tools
English
النص الكامل
إطبع هذه الصفحة
إعادة رسم سياسة الولايات المتحدة الأميركية
بعد عقود من السير في المفاوضات ومبادرات السلام الفاشلة حينًا ثم الإحجام عنها حينًا آخر، حان وقت تغيير السياسة الأميركية تجاه عملية تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وفيما يُعد التخلي عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب “السلام من أجل الازدهار” خطوة هامة، إلا أنها غير كافية لتجاوز الأمر الواقع، لذا على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتمد في صلب استراتيجيتها نهجًا قائمًا على الحقوق، بدلاً من إحياء عملية سلام تحتضر أو التخلّي ببساطة عن الانخراط الأميركي في تلك العملية.
من شأن هذا النهج، كما هو معرّف هنا بشكل عام، أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن الإنساني للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى. ومن شأنه كذلك إعادة التأكيد على حقوق الإسرائيليين في الأمن والسلام وحمايتها، وإيلاء اهتمام متساوٍ للحقوق الفلسطينية المهملة منذ فترة طويلة، بما في ذلك حرية التنقل والتحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة أو، بطرق محددة، داخل إسرائيل.1
إن اتخاذ هذا النهج كركيزةٍ أساسية يمكن أن يُسهم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين وعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان وإعادة بناء آفاق السلام الدائم. ومن إيجابياته أيضًا أنه أكثر انسجامًا مع السياسة العامة لإدارة الرئيس بايدن ويتطلب استثمارًا أقل، لا أكثر، من الجانب الأميركي.2
يقتضي مثل هذا النهج نبذ السياسات التي ترسّخ الأمر الواقع وتعمّق الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مسارًا مناهضًا للديمقراطية في أوساط صانعي القرار الإسرائيليين. وبالمثل، يتطلّب ذلك من الجانب الفلسطيني نبذ السياسات التي تغذّي التوجهات المناهضة للديمقراطية وتحدّ من المحاسبة والمساءلة أمام الشعب. إذًا، يستلزم هذا النهج القائم على الحقوق بشكل أساسي تحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الأشخاص والالتزام بالقانون الدولي. ولا تتعارض هذه المبادئ مع الحل على أساس الدولتين بل هي منفتحة على بدائل أخرى، وتدرك ببساطة أن أسسَ عملية السلام الحالية تُديمُ الاحتلال وتُعتبر غيرُ قادرة بنيويًا على تحقيق السلام والأمن الإنساني.
يجري تقديم هذا النهج القائم على الحقوق بتواضع، إذ ناقش أكاديميون وناشطون وصانعو السياسات جوانب منه سابقًا. وينبغي أن ينبثق بشكل عضوي من الاستماع إلى مخاوف الأشخاص المتضرّرين من النزاع، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكة أمان تصون لهم حقوقهم، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون.
يجمع هذا التقرير بعضَ خيارات السياسة العامة التي يمكن اشتقاقها من هذا النهج. وقد أجرى مؤلّفو التقرير على مدى عام ونصف مشاورات مع خبراء من خلفيات مهنية وشخصية متنوعة لمناقشة الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في ضوء الظروف المتدهورة للصراع. وأجروا كذلك نقاشات مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات المناصرة وقادة الفكر المنخرطين في مساعي دعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو القانون الدولي وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.
وقد حدّد مؤلّفو هذا التقرير أربع أولويات شاملة: أولًا، إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس؛ وثانيًا، إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي؛ وثالثًا، توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين؛ ورابعًا، دعم النُهج الجديدة المتعدّدة الأطراف والمساءلة. ولتعزيز هذه الأهداف، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:
التأكيد بوضوح أن الولايات المتحدة لن تدعمَ إلا حلًا بديلًا يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولن توافق على نظامين منفصلين وغير متساويين، نظرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
إعادة رسم العلاقة الثنائية الأميركية الفلسطينية من خلال العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والتعبير عن نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة.
العمل مباشرةً، ومع دول أخرى، على استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزامها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل دائم لحالة انعدام جنسيتهم.
تشجيع وتسهيل المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، حماس وفتح – مع أن الفلسطينيين مسؤولون عن تجديد حالتهم السياسية – بشرط أن تَحترمَ حماس القانون الدولي وتمتنعَ عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. وتحقيقًا لهذه الغاية وخدمةً لأهداف التجديد والتمثيل السياسي الفلسطيني، ينبغي التجشيع على إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاث المقترحة وتقديم الدعم لها.
السعي مع القيادة الفلسطينية إلى إصلاح نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين المحررين والمحتجزين لدى إسرائيل وعائلات قتلى العنف السياسي، وتوضيح أنْ لا حوافزَ تشجّعُ على العنف ضد المدنيين؛ وتسهيل إزالة القيود التشريعية التي وضعها الكونغرس على العلاقات الأميركية الفلسطينية وبرامج المساعدة؛ ومواصلة استخدام الصلاحيات التنفيذية لتضييق تفسير القيود المفروضة على المساعدات المقدّمة للفلسطينيين.
التعاون مع الجهات المعنية لإنهاء حصار غزة وانفصال القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف السياسات الأميركية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.
إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وإنهاء السياسات التي تعتبرها جزءًا من إسرائيل، والحرص على التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير القانونية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون.
إنشاء آليات للإشراف على الاستخدام النهائي والشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية الأميركية المنقولة إلى إسرائيل، وتحديد طرق منع استخدام المساعدات الأميركية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق الإنسان.
التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي والعمل بشكل تعاوني مع وكالات الأمم المتحدة والآليات المتعددة الأطراف الأخرى لدعم التوصيات الواردة في هذا التقرير.
تجنّب تأجيج سباق التسلح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
التأكد من امتثال القوانين واللوائح والاتفاقيات الاقتصادية الأميركية – وكذلك إدارة أي صناديق للمؤسسات، بما في ذلك تلك التي تدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية – للالتزامات القانونية، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، والتأكد من أنها تدعم تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
يجب أن تُسهم الأفكار والتوصيات التفصيلية التالية في أي نقاش عملي حول كيفية التعامل مع تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تساعد مشاركة الولايات المتحدة في تقديم حل سياسي عادل ودائم يعزز الكرامة الإنسانية والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس
لا يخفى أن المخاطر مُحدقة بآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، إذ فشلت اتفاقية أوسلو للسلام في تحويل العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب المحتل إلى علاقة تعايش بين دولة ودولة، ناهيك عن فشلها في إدارة الصراع. وما من إجماع على الحلول البديلة التي ظهرت وبدأت تكتسب زخمًا في المجتمعين. وعلى سبيل المثال، تظل الرؤى المختلفة التي يتبناها العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولة الواحدة متضاربة، فبعضها متجذرٌ في المساواة الديمقراطية و/أو الدولة الثنائية القومية، فيما البعض الآخر متجذرٌ في نظام هيمنةٍ منفصل وغير متكافئ.
في ضوء هذا الواقع الواضح، لا بد من اتباع نهج أميركي جديد لصنع السلام يتجنب العودة إلى مفاوضات الوضع النهائي أو التقدم بمبادرات خطط سلام جديدة وطموحة. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز الأولويات على حماية الأشخاص وحقوقهم، واتخاذ إجراءات مدروسة يمكن أن تغير الحسابات السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين، وخلق فرص لحلٍ سياسي مستدام. لا يهدف هذا النهج إلى تغيير المسار السلبي الذي تسلكه الأطراف فحسب، بل يصبّ أيضًا في إطار تعزيز ادّعاء الإدارة الجديدة بأنها تسعى إلى احترام قواعد النظام الدولي.3
إن رفع مستوى حماية حقوق الناس والحفاظ عليها لا يعني التخلي عن حل سياسي دائم وعادل وشامل كهدف من أهداف السياسة الأميركية. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون مقترحات السلام التي لا تحظى إلا بفرص ضئيلة للنجاح هدفًا في حد ذاتها، إذ إن تداعيات المفاوضات الفاشلة لا تقتصر على مجرّد تبديد التوقعات، بل تؤدّي أيضًا إلى تشجيع المتشدّدين وتزيد صعوبة حشد الدعم لتجديد المحادثات حين يصبح الظرف والتوقيت مؤاتيين. علاوةً على ذلك، لا ينبغي أن تصرف المفاوضات الانتباه عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والحقائق الجديدة على الأرض، وبالتالي الأوضاع المتدهورة للفلسطينيين.
في ظل سعي إسرائيل المستمر إلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، يجب على الإدارة الأميركية التأكيد بوضوح على أن البديل الوحيد المقبول هو المساواة الكاملة والحرية في التصويت لجميع الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل وولايتها القضائية. كذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى تضييق فجوة عدم التكافؤ في القوة بين إسرائيل دولة الاحتلال من جهة، والفلسطينيين الشعب المحتل من جهة أخرى، ووضع استراتيجيات لمواجهة العوائق الهيكلية الدائمة أمام حل النزاع، باعتبار أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يعيشون على قدم المساواة في رقعة الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
ولا بد أيضًا من إعادة تصوّر الأمن عند اتباع النهج القائم على الحقوق، لإيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ورفاههم. ومع أن الحفاظ على أمن إسرائيل سيظل أحد أهداف السياسة الأميركية، ويجب أن يبقى كذلك، لا ينبغي أن يأتي على حساب إنكار حقوق الفلسطينيين وأمنهم، أو أن يُستخدمَ كذريعةٍ لهذه الغاية.
وفي غزة، يعني ذلك العمل مع الحلفاء والآليات المتعددة الأطراف من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار، ومعالجة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بشكل مباشر، وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني عُزلوا عن بقية الأراضي المحتلة والعالم لأكثر من عقد من الزمن.4
أما في الضفة الغربية، فيجب أن تؤكد سياسة الولايات المتحدة على حماية حقوق الأرض والموارد، ودعم حرية الناس في التنظيم، والتجمّع، والعمل، والسفر، والعيش من دون تهديد بالتعرّض إلى النزوح، أو إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي القدس الشرقية المحتلة، على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالالتزامات السابقة والاتفاقيات الموقعة، والعمل على إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق، ودعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بالسكان الفلسطينيين.
وداخل إسرائيل، يجب على الولايات المتحدة، من خلال علاقاتها الثنائية، أن تشجّعَ الحكومة على ضمان حماية متساوية بموجب القانون لجميع المواطنين، ولا سيما في ضوء القانون الأساسي الذي يحمل عنوان “إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي”.5
إن الديناميكيات التي جعلت السلام بعيد المنال لم تولد إبان فترة إدارة ترامب. فقد شكّل تبني القيادة الإسرائيلية العلني للإجراءات التي تسعى إلى السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور المطّرد للحكم الديمقراطي الفلسطيني اتجاهًا واضحًا على مدى عقود. وفي حين أن سياسات جميع الإدارات الأميركية السابقة لم تكن فعالة إلى حد كبير في معالجة هذه الاتجاهات، يبقى أن ما ميّز نهج إدارة ترامب هو دعمها المطلق لطموحات إسرائيل الإقليمية القصوى، وحمايتها للحقوق التي تخص الإسرائيليين حصريًا، وتجاهلها التام للقانون الدولي وللمؤسسات المتعددة الأطراف.
وحتى لو تم التراجع عن سياسات ترامب، فمن غير المرجح أن يتغير المسار الحالي من دون التحدي المباشر للأمر الواقع المستمر. وتبعًا لذلك، ستصبح السيطرة الإسرائيلية راسخة أكثر من أي وقت مضى، وسيزداد التعدي على حقوق الفلسطينيين، وستتعاظم احتمالات اندلاع العنف. وستؤثر هذه المعطيات في الآفاق المتضائلة لحل الدولتين وتولّد زخمًا إضافيًا لحل بديل تقدّمه إسرائيل على أساس اللامساواة الدائمة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.
سيكون لهذه التوجهات تداعيات على الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها، وستجذبها إلى مشاركة دبلوماسية نشطة. إن بناء نهج قائم على الحقوق الآن يمكن أن يساعد في تخفيف هذا المسار أو حتى عكسه، ما يمهّد أرضيةً أكثر ثباتًا لإرساء السلام والدبلوماسية في المستقبل. ويمكن أن يتيح ذلك أمام الولايات المتحدة وحلفائها فرصًا للعمل في إطار القانون الدولي من أجل توفير الرفاه والأمن والحماية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
توصيات السياسة العامة الرئيسة
تبني نهج قائم على الحقوق يعطي الأولوية لحقوق الإسرائيليين والفلسطينيين وأمنهم.
إيضاح أن الولايات المتحدة لن تدعم أي توجّه يفشل في ضمان المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل وولايتها القضائية، وذلك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي
أعلنت إدارة ترامب خطتها “السلام من أجل الازدهار” في كانون الثاني/يناير 2020، وتوافق الخطة في جوهرها على السيطرة الإسرائيلية الدائمة على جزء كبير من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتتجاهل القانون الدولي كما أكّد عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016)، وتتجاهل المعايير الأميركية السابقة بشأن جميع قضايا الحل النهائي (مردّدةً الوصفات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو). تجعل هذه الخطة من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وهي لا تتطلب حتى موافقة الفلسطينيين على إبرام تسوية سياسية شاملة.
ينبغي على إدارة بايدن التنصل من خطة ترامب بأكملها. فإضافةً إلى أوجه القصور المحددة في الخطة من الناحية العملية، لن تنجح أي جهود ترمي إلى إعادة رسم العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين أو إلى إرساء بيئة مؤاتية لحل تفاوضي مستدام إذا بقيت خطة ترامب مطروحة.
ومع ذلك، هذه الخطوة وحدها ليست كافية، بل يتحتم على الإدارة الجديدة إلغاء العديد من الإجراءات الإضافية التي اتخذت في عهد ترامب والتي تضر بآفاق السلام. وعلى الولايات المتحدة أيضًا أن تحرصَ على توفير التمويل والموارد للأونروا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة التمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، وتوضيح موقفها بشأن القدس والمستوطنات، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة ومعاملتها كوحدة إقليمية وإدارية منفصلة.
أوقفت إدارة ترامب التمويل الأميركي للأونروا (الذي كان يمثّل في السابق ثلث ميزانية الوكالة) وسعت إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني (انظر الإطار 1). وكانت الوكالة تكافح بالفعل لتوفير الرعاية الصحية الأولية الأساسية والتعليم والإقراض الصغير وفرص العمل لأكثر من 5 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن ولبنان وسورية.6
الإطار 1: سياق مساهمات الولايات المتحدة للأونروا
تأسست الأونروا في العام 1949 بهدف توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم وفرص التوظيف للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وكذلك في الأردن ولبنان وسورية. وتستمد الوكالة 90 في المئة من تمويلها من المساهمات الطوعية التي تمنحها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.7
تقدم الوكالة دعمها اليوم إلى نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين، يُعرّفون بأنهم “الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين 1 حزيران/يونيو 1946 و15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم وموارد رزقهم نتيجة صراع اعام 1948،” ويشمل التعريف المتحدّرين من نسل هؤلاء وكذلك النازحين في أعقاب حرب العام 1967.8
راودت الولاياتَ المتحدةَ أحيانًا فكرةُ تغيير هذا التعريف كي تُقلِّلَ فعليًا عددَ اللاجئين الذين يحق لهم العودة إلى ديارهم (إسرائيل ترفض العودة) أو إعادة التوطين والتعويض كما نصَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وفي العام 2018، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن الولايات المتحدة قد تستأنف دفع مساهماتها للوكالة “إذا عدَّل القائمون عليها عددَ اللاجئين استنادًا إلى حساب دقيق”، في إشارة على الأرجح إلى الدعوات المطالبة بأن يقتصر العدد على مَن عايش نزوح العام 1948.9 لكن استبعاد ذراري اللاجئين سيتعارض مع القانون الدولي ومبادئ وحدة العائلة ومع معاملة مجموعات اللاجئين الأخرى التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.10 يُضاف إلى ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الوحيدة المخولة بتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني.
مع أن الولايات المتحدة سوف تستأنف بعض الدعم، ينبغي على إدارة بايدن أن تعترف علنًا بأهمية عمل الأونروا وبضرورة أن تواصل الدول الأخرى دعمها إلى حين التوصّل إلى حل دائم لإنهاء حالة انعدام الجنسية الفلسطينية.
ينبغي أن يشمل إعادة التمثيل الدبلوماسي مع الفلسطينيين إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وكذلك فصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها قبل أيار/مايو 2018. ستساعد هذه الخطوات المهمة في إعادة رسم العلاقات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية.
بالطبع، سيستغرق هذا الأمر بعضًا من الوقت ويقتضي توافر الإرادة السياسية. كذلك، تتطلّب إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التنسيق مع الكونغرس وتصاريح من إسرائيل. وسترغب منظمة التحرير الفلسطينية في الحصول على ضمانات بألّا يتم التعامل معها على أنها منظمة إرهابية خاضعة لقانون مكافحة الإرهاب (ATCA) قبل إعادة فتح البعثة في واشنطن، إذ يسمح هذا القانون للولايات المتحدة أن تحمّلَ منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الأضرار المدنية الناجمة عن العنف السياسي في الخارج إذا كان لها وجود رسمي في الولايات المتحدة أو كانت لا تمتثل لقانون تايلور فورس (الذي يحظر المساعدة الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية ما لم تصلح، من بين شروط أخرى، نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل المدانين بارتكاب أعمال عنف سياسي).
يتمتع بايدن بالسلطة التنفيذية اللازمة (إذا رغب في ممارستها) لتجاوز قيود الكونغرس التي تمنع منظمة التحرير الفلسطينية من العمل في الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع أن يؤكد لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أنهما لن تكونا مسؤولتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الحالي. وإلى حين العمل على إيجاد طرق لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، يجب على الإدارة الأميركية أن تسمحَ لبعثة أجنبية صديقة في واشنطن بتسهيل الخدمات القنصلية للفلسطينيين وأولئك الذين يحتاجون إلى وثائق مصدقة لإجراءات التجارة أو الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، على الإدارة الجديدة إبلاغ الإسرائيليين والفلسطينيين بأن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس وغزة لا يزال متوافقًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ويمكن العمل مع إسرائيل لضمان الإجراءات التالية: أولًا، السماح بإجراء انتخابات السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وفقًا للممارسة المتّبعة في الانتخابات السابقة والاتفاقيات الموقعة؛ ثانيًا، السماح بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة منذ عام 2000؛ وثالثًا، منع إخلاء الفلسطينيين المقدسيين ووقف هدم المنازل. ويجب على الولايات المتحدة أن تتخلى بوضوح عن مسعى تحديد السيادة على القدس الوارد في خطة “السلام من أجل الازدهار”. وعلى الإدارة الأميركية كذلك أن توقف السياسات التي تعامل غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين منفصلتين، وأن تحرص على استخدام مصطلح “محتلة” للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، في جميع الوثائق الحكومية.
وعلى الإدارة أن تصدرَ بيانًا سياسيًا لا لبس فيه بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك التفريق بين إسرائيل والأراضي المحتلة في جميع المعاملات الثنائية، كما ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (الذي يلزم الدول بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي). سيضمن هذا الإجراء ألا تُسهِّل الولايات المتحدة عن غير قصد توسيع المستوطنات الإسرائيلية أو أنشطة الشركات المرتبطة بها، وألا تسهمَ في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الإقامة الفلسطينية، والإخلاء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل.
يتعين على الإدارة أن تتجنب التمييز بين أنواع المستوطنات الإسرائيلية، ما من شأنه أن يتعارض مع المبدأ الراسخ القاضي بعدم قانونية الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو العدوان. ويترافق ذلك مع التأكيد على أن عدم اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا ينبغي أن يكون مساويًا لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي يقودها المجتمع المدني. وعلى الإدارة كذلك أن تعلن أنها تعتبر هذا النشاط جزءًا من حرية التعبير التي يصونها الدستور وليس مناهضًا لها، أو معاديًا للسامية في حد ذاته.12 ستتطلب استعادة السياسة الأميركية بشأن المستوطنات أيضًا التراجعَ عن تمديد إدارة ترامب للاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الضفة الغربية، والسماح بوسم البضائع المنتجة في المنطقة “ج” من الضفة الغربية بعلامة “صُنعَ في إسرائيل”.13 في الأشهر التي سبقت مغادرة ترامب منصبه، بذل وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو جهودًا غير عادية لاحتضان المستوطنات والتجارة الأميركية معها، ما قوَّض جهود السلام والسياسة الأميركية والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة.14
يجب على إدارة بايدن حظر المساعدات أو القروض التنموية للمنشآت الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقديم إرشادات واضحة لمؤسسة تمويل التنمية الدولية التي تدير الأموال الأميركية والدولية للتقيّد بالالتزامات المستحقة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنهاء الإعفاء الضريبي الممنوح إلى المؤسسات الأميركية غير الربحية التي تموّل المستوطنات الإسرائيلية.15
توصيات السياسة العامة الرئيسة
إعادة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها على أنها جزء من إسرائيل.
العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والإشارة إلى توفير الدعم لفتح سفارة أميركية في فلسطين في القدس الشرقية عند التوصّل إلى تسوية، واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على المؤسسات الوطنية الفلسطينية والإقامة في القدس.
العمل على استئناف التعهدات المالية من الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى للأونروا، كي تتمكّن من الوفاء التام بالتزاماتها، والاعتراف بالدور المهم الذي تؤدّيه إلى حين التوصّل إلى حل دائم.
التأكد من أن جميع الوكالات والهيئات الفدرالية، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية، التي تدير البرامج وتقدّم القروض والمنح للتنمية الفلسطينية، لا تعود بالنفع على الشركات الإسرائيلية التي تتربّح من توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة أو تسهّل هذه العملية.
توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين
يُفاقم النهج الأميركي الذي ما انفك يولي الأولوية إلى الحفاظ على عملية السلام أو إعادة إطلاقها والعبث بالأراضي على حساب صون الحقوق وحمايتها، التوجهات السلبيةَ ويحدّ من مساءلة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. لقد تزعزع الحكم الديمقراطي الفلسطيني وانقسم بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وانتشر الفساد. في غضون ذلك، أدّت سيطرة إسرائيل الشاملة على الأراضي، بما في ذلك فرض حصار على غزة، إلى زيادة الصعوبات أمام الإدارة الفلسطينية وإعاقة عملية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية يُعتد بها. ولم تجد هذه السيطرة الإسرائيلية أي رادعٍ يُذكر. وقد أدى هذا التساهل مع السياسات الإسرائيلية، فضلاً عن زيادة المساعدة الأمنية الأميركية، إلى حرف النقاش العام داخل إسرائيل حول الأراضي المحتلة. ونادرًا ما تخضع إسرائيل لمعايير الشفافية وحقوق الإنسان التي يتم تطبيقها عادةً على المتلقين الآخرين للمساعدات الأميركية.
على الولايات المتحدة اتّخاذُ مجموعة من الإجراءات التي تعزّز في كلا المجتمعين السياسات القائمة على السلام واحترام الحقوق. لقد أدّى غياب مثل هذا النهج إلى تأثير مشوِّه في إسرائيل بشكل خاص.
العلاقات الأميركية الفلسطينية
ينبغي البدء في إعادة رسم علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين وهيئاتهم الوطنية من خلال دعم الانتخابات وعملية التجديد السياسي، والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية المستدامة الفلسطينية.
التجديد السياسي الفلسطيني
منذ زمن بعيد، لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية (وهي الهيئة التمثيلية المعترف بها دوليًا للشعب الفلسطيني) وكذلك السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمثّل مصالح شعوبها أو تخضع للمساءلة أمامهم. حيث لم تُعقد انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية منذ 2005 و2006 على التوالي.
افتقرت الانتخابات التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية (انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني) التي جرت في العام 2018 إلى الشفافية والمشاركة الشعبية في ظل نظام محاصصة بالٍ. وقد أعاقت سيطرة فتح الحصرية على الهيئات الوطنية الفلسطينية وحكمها بالمراسيم الرئاسية المساعي الجادّة نحو تحقيق المصالحة الوطنية مع حماس. وحتى إن كانت التدخلات والقيود الخارجية مسؤولة جزئيًا عن بعض أوجه القصور في شرعية الهيئات الوطنية الفلسطينية، تظل هذه العيوب الكبيرة على مستوى الحكم مسؤولة عن عرقلة آفاق السلام.
في كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نيته إجراء الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31 آب/أغسطس.16 ولا شكّ أن الانتخابات خطوةٌ مهمة في طريق التجديد السياسي الفلسطيني، وينبغي على السلطة الفلسطينية التي تتسيّدها فتح، وعلى حركة حماس أيضًا أن تحرصا على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وعلى الإدارة الأميركية أن تدعم هذا الجهد، وأن تثني إسرائيل عن تقييد الحركة أو الحملات الانتخابية أو الاقتراع أو تقييد ترشيح المقدسيين والمعارضين لحركة فتح، وأن تحترم بالكامل نتائج الانتخابات. وينبغي أن يكون تعامل الولايات المتحدة مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة (مهما كانت احتمالات تحالف الوحدة) مرهونًا بالتقيّد باحترام القانون الدولي وعدم استخدام العنف ضد المدنيين (على سبيل المثال، المصادقة على مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية). فقد فشلت شروط الرباعية الثلاثة (الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف) من الناحية العملية، وباتت تشكل عقبةً أمام التقدّم، وتستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وتتجاهل مفاوضات إسرائيل المستقلة مع حماس وكذلك رفض إسرائيل القبول بالتزامات مماثلة.
في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن توضح، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، توقعاتها بأن الحكومة الفلسطينية سوف تكبح الفساد وتدير الأموال العامة بطريقة شفافة.
المساعدات الاقتصادية والإنمائية
في العام 2015، خفض قانون “تايلور فورس” بشكل كبير المساعدة الثنائية الأميركية للفلسطينيين، وفي العام 2018، أنهتها إدارة ترامب تمامًا. وسيكون استئناف المساعدات للفلسطينيين أمرًا صعبًا لأن قانون تايلور فورس يحظر معظم المساعدات التي تدعم بشكل مباشر السلطة الفلسطينية ما لم تتوقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عن الدفع للأسرى الفلسطينيين المدانين بالعنف السياسي أو لعائلات الذين قُتلوا أثناء ارتكابهم هذه الأعمال. إذًا، يفترض قانون تايلور فورس أن مثل هذه المساعدات تحفز المقاومة الفلسطينية المسلحة، ويشترط بالتالي توفير الرعاية الاجتماعية إلى الفلسطينيين بناءً على نظام الحاجات البحتة. ومع ذلك، قد لا تكون السلطة الفلسطينية في وضع يسمح لها بإنشاء نظام قائم على الحاجات البحتة، نظرًا إلى أن نصف السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يحتاجون حاليًا إلى مساعدات إنسانية.17
لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتّخذ موقفًا داعمًا عندما تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاح نظام الدفع هذا، ويجب أن تستجيب الإدارة للطلبات المعقولة للحصول على مساعدات مالية، وأن تعمل مع الكونغرس لتسهيل هذه المساعدات، والاعتراف بأن جميع العائلات المعوزة تحتاجها بشكل شرعي. قد يكون هناك ما يبرّر الإصلاحات، لكن إسرائيل والولايات المتحدة قبلتا بهذا النظام حتى العام 2015، لأن هذه الأنواع من المدفوعات ليست غريبة في سياق النضالات الوطنية من أجل الاستقلال والعنف السياسي المرتبطة به جميع الأطراف.18 تجدر الإشارة أيضًا إلى السهولة التي تسجن بها إسرائيل الشبان الفلسطينيين وكذلك الأطفال، غالبًا من دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة.19
لم يتم التحقق من وجود رابط بين المساعدات المقدّمة والعنف، وسيكون من الصعب إثباته في ضوء الاستفزازات الناجمة عن سياسات إسرائيل العنيفة في الأراضي المحتلة. مع ذلك، وللمساعدة في إعادة رسم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وتوخيًا للوضوح، على السلطة الفلسطينية أن تبذل قصارى جهدها لكي تُثبِت، في سياق سياسة المدفوعات وأي إصلاحات لها، بأن هذه المساعدات للأسرى لا تحفّز على العنف.
وبينما تسعى الإدارة الأميركية مع الكونغرس والقيادة الفلسطينية إلى تذليل التحديات المرتبطة باستئناف المساعدة الثنائية، ينبغي على السلطة التنفيذية أن تستمر في تفسيرها الضيق للمساعدات التي “تصبّ بشكل مباشر في صالح” السلطة الفلسطينية، وأن تجد سبلًا لدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية من خلال الهيئات المتعددة الأطراف على سبيل المثال.
ولدى استئناف المساعدات الثنائية الأميركية، يجب الحرص على أن تكون مستدامة ومتماشية مع أهداف التنمية الفلسطينية. وينبغي لبرامج المساعدات الأميركية المستقبلية أن تشجع على التطور الديمقراطي الفلسطيني، ومشاركة المجتمع المدني، وتجنّب تأجيج التوجهات الاستبدادية عن غير قصد، أو إضفاء الطابع الأمني على علاقة السلطة الفلسطينية بشعبها.
توصيات السياسة العامة الرئيسة
ينبغي الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل مع إسرائيل، والفلسطينيين، والدول الإقليمية مثل الأردن ومصر لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويجب أن يكون تعامل الولايات المتحدة مع القيادة الفلسطينية المستقبلية وربما الموحدة، مشروطًا فقط باحترام القانون الدولي وموافقة أي حكومة (سواء تحالف أو غيره) على الامتناع عن العنف الذي يستهدف المدنيين الإسرائيليين.
السعي مع الجهات المعنية إلى إنهاء حصار غزة وفصل القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف سياسة وزارة الخارجية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.
دعم التحسينات على مستوى الحكم الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية والمساءلة والعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية على إصلاح نظام المدفوعات للأسرى الفلسطينيين وعائلات قتلى العنف السياسي كجزء من هذا الجهد.
توجيه التمويل الأميركي للفلسطينيين من خلال الهيئات المتعددة الأطراف من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية إلى حين استئناف الخدمات والمساعدات الأميركية، وكذلك تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وعند استئناف التمويل الثنائي، يجب أن تكون جميع المساعدات مستدامة وأن تدعم أهداف التنمية الفلسطينية.
العلاقات الأميركية الإسرائيلية
حذَّر المسؤولون الدوليون إسرائيلَ مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات عديدة من الضرر الطويل الأمد الذي تسببه لنفسها سياساتها تجاه الفلسطينيين، وكذلك من هشاشة الدعم الدولي لها إذا واصلت هذه السياسات. وليست تلك التحذيرات مستغربة، إذ تستمر إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي، وتتبنى سياسات لحقها ضَربٌ من التبعات والعواقب في أغلب الحالات التي طُبِّقت فيها دوليًا، ناهيك عن أنها في وضع هش فعلًا بسبب ارتباط اقتصادها ومجتمعها بالنظم العالمية. وعلى الرغم من كل ذلك، ظلت إسرائيل إلى حدٍ كبير غير خاضعةٍ لأيٍّ من معايير المحاسبة العالمية ولم تتكبد أي تكاليف تُذكر، بل توسّعت علاقاتها التجارية في السنوات الأخيرة، واستفاد اقتصادها على الرغم من انتهاجها سياسات أكثر فظاعة تجاه الفلسطينيين. وهكذا، وَجدت إسرائيلُ منطقًا لاستمرار هذه السياسات.
ومن دون إدراك المنطق السياسي الذي يحكم الخيارات الإسرائيلية، ما من فائدة تُجنى من محاسبة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. يبلغ عدد سكانها من المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية اليوم حوالى 667000 مستوطن (انظر الإطار 2).20 وتُعدّ مصفوفة السيطرة والقيود الإسرائيلية المفروضة على السكان الفلسطينيين وحياتهم اليومية على ارتباط أساسي بنمط الاستيطان الإسرائيلي.
الإطار 2: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية والقدس الشرقية
شرعت إسرائيلُ في بناء المستوطنات بُعيد احتلالها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في الحرب العربية الإسرائيلية في حزيران/يونيو 1967. وتضمّ الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اليوم 145 مستوطنة21 إضافةً إلى 135 بؤرة استيطانية.22
توسعت المستوطنات الإسرائيلية بشكل مطرد على مر السنين، إذ بلغَ عدد المستوطنين الإجمالي في الضفة الغربية 116300 مستوطن عشية اتفاقيات أوسلو الموقعة في العام 1993.23 وبحلول العام 2019، قُدّر هذا العدد بحوالى 441600 مستوطن يُضاف إليهم 225178 مستوطنًا في القدس الشرقية، ليبلغ عدد المستوطنين الإجمالي 666778 مستوطنًا.24 وفي حين أجلَت إسرائيل 9000 مستوطن من غزة ومن جيبٍ صغير في شمال الضفة الغربية في العام 2005، عكفت منذ ذلك الحين على ترسيخ المستوطنات وتوسيعها في أماكن أخرى.25 وتُعد المستوطنات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويُشار إليها على هذا النحو في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 في العام 2016 . وثمة علاقة بين المستوطنات وعمليات النزوح العديدة ومصادرة الأراضي والقيود على الحركة والحريات الأساسية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.
في الفترة ما بين العامين 1995 و2019، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ستة من أصل سبعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بخصوص إسرائيل أدانت مصادرة الأراضي و/أو وصفت المستوطنات بأنها غير شرعية و/أو دعت إلى وقفها. وفي العام 2016، امتنعت إدارة باراك أوباما وجو بايدن عن التصويت على القرار السابع.
لقد كان مشروع الاستيطان الإسرائيلي يهدف بشكل صريح في الكثير من الأحيان إلى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. وقد ولَّدت المستوطنات شعورًا في أوساط الإسرائيليين بأن تحقيق حل الدولتين أمر صعب للغاية، في حين أن مواصلة الاحتلال من دون تكلفة أمر سهل.
ولم تلقَ وجهة النظر هذه معارضةً جديةً قط، إذ إن السياسة الأميركية لم تحاسب إسرائيل مطلقًا بصفتها الضامن لإفلات إسرائيل من العقاب. ولم تعطِ الولايات المتحدة إسرائيل أي سبب يدفعها إلى تغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين، بل منعت الإجراءات الأميركية الأطرافَ الثالثة والمنتديات الدولية من تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي.
أعاد الرأي العام الإسرائيلي وطبَقَته السياسية ضبطَ مواقفهما وفقًا لذلك. بالطبع، تُعزى إعادة التقويم إلى أسباب أخرى، بدءًا بتأثير الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ووصولًا إلى القيادة الراكدة للمعسكر الليبرالي الإسرائيلي لفترة جيلٍ واحد على الأقل. لكن ظاهرة إفلات إسرائيل من العقاب هي في المقام الأول ما يمنع فتح نقاش جادّ بشأن مستقبلها مع الفلسطينيين.
ففي غياب المساءلة، تحوّل مركز ثقل الخطاب الإسرائيلي وزاد تهميش السياسات الداعمة للسلام.
ليس من دور صانعي السياسة الأميركيين قيادة معسكر معارضة متجدّد في إسرائيل. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تساعدَ في تهيئة الظروف اللازمة لتوجيه السياسة الإسرائيلية نحو السعي إلى تحقيق سلام قابلٍ للحياة وإنهاء الاحتلال. وهذا يستدعي من الولايات المتحدة تغييرَ طريقة تعاملها مع العلاقات الثنائية، وتحديدًا تعاملها مع المستوطنات وتصرّفها في المحافل الدولية. وهذا يتطلب أيضًا وضعَ شروطٍ على المساعدات الأمنية غير المسبوقة لإسرائيل، والتي تشكل ما يقرب من 60 في المئة من إجمالي المساعدات العسكرية الأجنبية، إضافةً إلى التعاون الأميركي الإسرائيلي في مجالي الأبحاث والتنمية، ما أسهم في ضمان أمن إسرائيل وازدهارها.26 لا ينبغي إعفاءُ إسرائيل في الممارسة العملية من الالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي ومقتضيات حقوق الإنسان، مثل تلك المنصوص عليها في قانون ليهي.27
وعلى الأقل، يجب ألا تُسهم المساعدةُ الأميركية لإسرائيل في تشريد الفلسطينيين ومفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، دعا أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى وضع شروط على المساعدة لإسرائيل إذا ما مضت قدمًا في ضم أي جزء من الضفة الغربية رسميًا.28 وقد لجأت إسرائيل منذ ذلك الحين إلى تأجيل بسط سيادتها هناك، لكنها تواصل الضم الفعلي وتوسيع المستوطنات. وفي حين أن فرض قيود على المساعدات الأميركية لإسرائيل ليس أمرًا مطروحًا في الوقت الحالي، فإنه ينبغي وضع آليات للإشراف والمراقبة، كما يجب عدم تشجيع الإجراءات على الأرض التي تتعارض مع القانون والمصالح الأميركية ومع السلام.
على الولايات المتحدة توجيه رسالة واضحة ومتسقة إلى إسرائيل مفادها أن انتهاك المعايير وتقويض أهداف السياسة الأميركية سيؤديان إلى عواقب، وإلا لن يتغير مسار السياسة الإسرائيلية وسيُغلق الباب أمام حل النزاع سلميًا وحل الدولتين. وهذا بمثابة إنذار مهم لإسرائيل، إذ بات عددٌ متزايدٌ من المراقبين – من متخصّصين وممارسين قانونيين،29 وهيئات خبراء في الأمم المتحدة،30 ومنظمة حقوق الإنسان31 الأكثر احترامًا في إسرائيل – يصفون الوضع الراهن بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل بأنه نظام فصل عنصري.
توصيات السياسة العامة الرئيسة
إعادة التأكيد على الموقف الأميركي بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، ووضع حد للسياسات التي تتعامل معها على أنها جزء من إسرائيل، وتجنب التمييز بين المستوطنات، وأيضًا تفادي خوض مفاوضات مع إسرائيل حول ما يسمى التوسع الاستيطاني المقبول.
التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون. وإعادة فرض القيود الجغرافية على إسرائيل والولايات المتحدة في مؤسسة البحث والتطوير الصناعي الثنائية القومية، ومؤسسة العلوم الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والصندوق الأميركي-الإسرائيلي للبحوث الزراعية والتنمية.
دعم جهود الدول الأخرى أو الاتحاد الأوروبي أو الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى للتفريق بين إسرائيل والأراضي المحتلة في القوانين والأنظمة.
إنشاء آليات لمراقبة استخدام إسرائيل الشفاف والخاضع للمساءلة لمعدات الدفاع الأميركية للمساعدة في إنفاذ القوانين الفدرالية، ثم تحديد طرق لمنع استخدام المساعدة الأميركية لتسهيل عمليات الضم أو انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
دعم المقاربات الجديدة المتعددة الأطراف والمساءلة
نظرًا إلى أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات لمواجهة التحديات العابرة للحدود وإعادة تصور المشاركة العالمية للولايات المتحدة، يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق درجة أكبر من المصداقية والاتساق في الداخل والخارج. وستكون مسألة السلام الإسرائيلي الفلسطيني واضحة في هذا الصدد نظرًا إلى تزايد بروزها في أوساط المجتمع المدني الأميركي بشقيه الجمهوري والديمقراطي، ونظراً إلى استمرار تناقضات السياسة الأميركية وإخفاقاتها في هذه القضية.
يجب أن يبدأ طي صفحة المقاربات المعتمدة على المعاملات التي انتهجتها إدارة ترامب، وذلك من خلال دعم المنتديات الدولية والآليات المتعددة الأطراف والدول الأخرى لدعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد بشكل موثوق. ولا ينبغي استخدام القوة الدبلوماسية الأميركية لحماية إسرائيل من المساءلة أو لمنع دول أخرى أو هيئات متعددة الأطراف من اتخاذ تدابير لوقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي يحرمُ الفلسطينيين فعليًا فرصةَ الانتصاف وجبر الضرر واستخدام أدوات لردع التعدي الإسرائيلي.
في الماضي، نقضت الولايات المتحدة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة بإجماع واسع لدعم حقوق الفلسطينيين، وقطعت تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على خلفية قبولها عضوية فلسطين، وقيَّدت مساهماتها في هيئات متعددة الأطراف بسبب المواقف إزاء الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني، أو انسحبت من تلك الهيئات تمامًا؛32 وحاولت كذلك منع إنشاء قاعدة بيانات الأمم المتحدة عن المستوطنات،33 وسعت إلى ثني الاتحاد الأوروبي وأيرلندا عن وضع علامات على منتجات المستوطنات أو حظر استيرادها. وشكّلت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافهم أميركيين أو إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب أكثر الأمثلة فظاعة حتى الآن على إساءة استخدام السلطة لمنع المساءلة.34
صحيحٌ أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (والمؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) قائمة منذ ما يقرب من عشرين عامًا، إلا أنها غير فعّالة إلى حدٍّ كبير. فعند استكشاف طرق جني فوائد أكبر من المحافل المتعددة الأطراف، على إدارة بايدن النظر في تمكين الرباعية بطرق جديدة و/أو إنشاء تحالفات وهياكل جديدة، سواء كانت دائمة أو متخصّصة بطبيعتها. لذلك، يُعتبر التعاون الوثيق مع أوروبا أحد السبل المحتملة. وفي هذا الصدد، يبدو أن مجموعة اتصال جديدة تشكلت إبان عهد ترامب تحت مسمّى مجموعة ميونيخ (وتضم ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر) كانت مرنة إلى حد ما في الاستجابة لخطر الضم.35
وتؤكد ردود المجموعة على أهمية المشاركة النشطة للأردن ومصر في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني. فالأردن شريك هام ومستقر للولايات المتحدة في المنطقة، يعمل على نقل الرسائل ويحافظ على درجة من الثقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. لكن إدارة ترامب همّشت الأردن بسبب رفض المملكة دعم نهج الولايات المتحدة، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالقدس ووضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يستضيف الأردن الكثيرين منهم. أما مصر، فتشكّل بدورها لاعبًا مهمًّا في ما يتعلق بغزة، ووسيطًا بين حماس وإسرائيل من جهة وبين حماس والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
ينبغي على الولايات المتحدة إذًا أن تعملَ مع الأردن ومصر، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى حيثما أمكن، وذلك للأسباب التالية: أولًا، من أجل وقف الضم الفعلي للضفة الغربية والسياسات الإسرائيلية الأخرى التي تنتهك الحقوق الفلسطينية؛ وثانيًا، لإنهاء الحصار على غزة؛ وثالثًا، لتشجيع التجديد السياسي الفلسطيني وتحقيق المصالحة.
حين توسطت إدارة ترامب في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية (الإمارات العربية المتحدة36 والبحرين37 والمغرب38 والسودان39)، عرضت حوافز مختلفة تحمل تداعيات سلبية محتملة حيال السلام الأوسع والاستقرار الإقليمي ومصالح أميركية أخرى. فمن المرجح أن تؤدي المبيعات المخطَّط لها للأسلحة المتقدّمة إلى تصعيد الصراع الإقليمي في منطقة تشهد العديد من الحروب المستمرة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.40 لذلك، على الإدارة الجديدة المساعدة في تقليل مخاطر سباق التسلّح المتسارع وتشجيع السلوك المعياري من قبل متلقّي المساعدة الأمنية الأميركية. كذلك، تهدّد الإنجازات الأميركية المحددة بموجب اتفاقيات التطبيع بتقويض القانون الدولي في الصحراء الغربية، وتصعيد الصراع هناك، وزعزعة استقرار مرحلة الانتقال الديمقراطي الهش في السودان.
إن أي دعم أميركي للتطبيع لا ينبغي أن يأتي على حساب تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، بل يجب أن يصب في خدمته. فعلى سبيل المثال، ما لم توضع ضوابط كافية لضمان عدم استفادة مؤسسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية من الاتفاقيات، فقد تقوّض المبادرات – مثل صندوق أبراهام الأميركي والإماراتي وإلاسرائيلي ومبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام التي أُقرَّت مؤخرًا – حقوق الفلسطينيين ومستقبل اقتصادهم، وكذلك احترام القانون الدولي.
توصيات السياسة العامة الرئيسة
إعادة التأكيد على القانون الدولي بوصفه أحد المرجعيات.
الامتناع عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى التمسك بالقانون الدولي أو إنفاذ التزامات إسرائيل كقوة احتلال، والتعاون مع الحلفاء والآليات المتعددة الأطراف للتخفيف من حدة الصراع ومنع العنف.
العمل مع الكونغرس لإزالة قيود التمويل المتعلقة بالتحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة أو قف المساعدات عن مؤسسات قبلت فلسطين في عضويتها؛ ودعم العمل المستمر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تمكّن وتدعم تشييد وتوسيع واستدامة المستوطنات الإسرائيلية.
تجنّب تأجيج سباق التسلّح الإقليمي من خلال عدم ربط عمليات نقل الأسلحة الأميركية باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
العمل مع الدول الأخرى وإسرائيل لضمان أن أي اتفاقيات تطبيع أو صناديق مشاريع تم إنشاؤها لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، بما في ذلك صندوق أبراهام ومبادرة الاستثمار المشترك من أجل السلام، تمتثل للالتزامات القانونية ودعم حقوق الإنسان في المنطقة.
شُكر وتقدير
أُعدت هذه الورقة تتويجًا لسلسلة مكثفة من الاجتماعات والمشاورات التي عُقدت بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وشباط/فبراير 2021 لتقييم سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل-فلسطين ودراسة كيف يمكن للإدارة المقبلة إعادة رسم مشاركتها في جهود صنع السلام. يُعرب المؤلّفون عن امتنانهم للمشاركين في المشاورات على وقتهم ومساهماتهم في المراحل المختلفة لصياغة التقرير. والشكر موصولٌ للسفيرة جينا أبيركرومبي وينستانلي وروبرت دانين لمراجعتهما الثاقبة والشاملة للمسودة الأولية من هذا التقرير.
المؤلفون وحدهم مسؤولون عن المحتوى النهائي لهذا التقرير، ولا تتبنى مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسسية حيال قضايا السياسات العامة. إن الآراء الواردة في هذا التقرير لا تعبّر إلا عن آراء مؤلّفيها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مؤسسة كارنيغي أو فريق عملها أو مجلس أمنائها.
وبالمثل، لا تعبر الآراء الواردة في هذا التقرير عن مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط بصفته المؤسسية ولا عن آراء أعضاء مجلسه الدولي أو كبار مستشاريه.
© 2021 مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، جميع الحقوق محفوظة
هوامش
1 عند اتباع نهج قائم على الحقوق يسعى إلى التركيز على المعايير والقيم والقواعد المعترف بها عالميًا والتمسك بها، ينبغي أن تشمل المصادر المرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، A / Res / 3 / 217A)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (دخل حيز التنفيذ في عام 1976، ووقعته الولايات المتحدة عام 1977)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دخل حيز التنفيذ في العام 1976، ووقعته الولايات المتحدة العام 1977 وصادقت عليه العام 1992)؛ وبروتوكوليه الاختياريين. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على البروتوكولين الاختياريين، إن العديد من القواعد الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تشكّل أيضًا جزءًا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحت القسم 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، الذي ينص على أن “من الأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تعزيزُ احترام البلدان كافة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.” وبخلاف بعض الاستثناءات، لا يجوز نقل أي مساعدة أمنية إلى دولة ذات سجل من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا،” والتي تشتمل بموجب تعريفها على التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاعتقال المطوَّل من دون توجيه اتهامات أو محاكمة؛ وغيرها من الإجراءات الصارخة التي تنكر حق الإنسان في الحياة أو الحرية أو الأمن.
2 البيت الأبيض، “التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي،” آذار/مارس 2021،
3 المرجع السابق.
4 “المؤشرات”، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population.
5 للاطلاع على مناقشة حول القانون الأساسي، إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي، انظر، زها حسن، “خطة ترامب لإسرائيل وفلسطين: خطوة أخرى بعيدًا عن السلام،” مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، https://carnegieendowment.org/2018/12/11/trump-s-plan-for-israel-and-palestine-one-more-step-away-from-peace-pub-77905.
6 “لاجئو فلسطين”، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، https://www.unrwa.org/palestine-refugees.
7 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “كيف تموَّل الأونروا”،
8 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “اللاجئون،” https://www.un.org/en/global-issues/refugees
9 “المبعوثة الأميركية هايلي تشكك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين،” وكالة رويترز للأنباء، آب/أغسطس 28، 2018، https://www.reuters.com/article/us-usa-palestinians-un/u-s-envoy-haley-questions-palestinian-refugee-numbers-idUSKCN1LD2AA.
10 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “استفسارات عامة،” https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
11 مايكل ويلنر، “وزارة الخارجية تُسقِط صفة ’المحتلة‘ عن الأراضي الفلسطينية في التقرير،” جيروساليم بوست، 21 نسيان/أبريل 2018، https://www.jpost.com/american-politics/state-dept-drops-occupied-reference-to-palestinian-territories-in-report-551365.
12 صدر إعلان القدس حول معاداة السامية، الذي وضعه ما يزيد على 200 باحث جُلُّهم من اليهود – ومنهم كثيرون بارزون في أبحاث الهولوكوست ومعاداة السامية والدراسات اليهودية والشرق أوسطية المعاصرة – في آذار/مارس 2021. تُثير المادة 14 من إعلان القدس حول معاداة السامية هذه النقطة بشأن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. انظر، “إعلان القدس حول معاداة السامية،” https://jerusalemdeclaration.org/.
13 إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، “تمييز بلد المنشأ للمنتجات من الضفة الغربية وغزة”، السجل الفدرالي، 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28547/country-of-origin-marking-of-products-from-the-west-bank-and-gaz
14 يولاند كنيل، “بومبيو يقوم بزيارات غير مسبوقة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والجولان”، بي بي سي نيوز، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008
15 أوري بلاوو، “تحقيق هآرتس: المانحون الأميركيون قدموا للمستوطنات أكثر من 220 مليون دولار في صناديق معفاة من الضرائب على مدى خمس سنوات،” هآرتس، 7 كانون الأول/ديسمبر 2015، https://www.haaretz.com/haaretz-investigates-u-s-donors-to-israeli-settlements-1.5429739.
16 ناثان ج.براون وزها حسن، “تخفيف التشاؤم حيال الانتخابات الفلسطينية المقبلة،” مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 4 آذار/مارس 2021، https://carnegieendowment.org/2021/03/04/slightly-dialing-back-cynicism-about-palestine-s-upcoming-elections-pub-83976
17 “تقرير إلى لجنة الاتصال المخصصة، مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،” 23 شباط/فبراير 2021، https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_report_to_the_ahlc_-_february_2021_0.pdf
18 انظر هورست كلاينشميت، “دور صندوق المساعدة والدفاع الدولي،” شهادة ألقيت في مؤتمر الحركة الدولية المناهضة للفصل العنصري، 10-13 تشرين الأول/أكتوبر 2004، مركز توثيق غاندي-لتولي، http: //disa.ukzn. ac.za/gandhi-luthuli-documentation-centre/role-international-defence-and-aid-fund.
19 منذ العام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية 800 ألف فلسطيني في الأراضي المحتلة -40 في المئة من الرجال الفلسطينيين -وأحالتهم إلى محاكم عسكرية بمعدل إدانة يقارب 100 في المئة. تتفردُ إسرائيلُ أيضًا بمحاكمة الأطفال في محاكم عسكرية، حيث يتم احتجاز ما بين 500 و700 طفل فلسطيني كل عام، ويروي الكثيرون عن تجارب العنف الجسدي والإساءة اللفظية والاستجواب من دون حضور أفراد الأسرة. انظر يارا هواري، “تعذيب الفلسطينيين الممنهج في المعتقلات الإسرائيلية،” الشبكة ، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، https://al-shabaka.org/briefs/the-systematic-torture-of-palestinians-in-israeli-detention/؛ “الاعتقال العسكري،” المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، “https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention؛ و “التقرير العالمي 2021: إسرائيل وفلسطين،” هيومن رايتس ووتش، https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/israel/palestine.
20 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population؛ و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem
21 هناك 132 مستوطنة في الضفة الغربية و13 مستوطنة في القدس الشرقية. انظر “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population؛ و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem. انسحبت إسرائيل من غزة في العام 2005 ورحَّلت 9000 مستوطن من إحدى وعشرين مستوطنة. انظر “فك الارتباط عن غزة – التقرير الدوري للمبعوث الخاص (أيلول/سبتمبر 2005)، “نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، 22 أيلول/سبتمبر 2005، https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205164/#:~:text=Non-UN document-,Gaza disengagement – Special Envoy periodic report (Sept.,2005)/Non-UN document&text=The recent disengagement from the,swiftly and with minimal incident؛ و”فك ارتباط إسرائيل عن غزة وبضع مستوطنات في الضفة الغربية،” تقارير من زيارات المسؤولين مرفوعة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشرين الأول/أكتوبر 2005، https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-109SPRT23820/html/CPRT-109SPRT23820.htm
22 البؤر الاستيطانية هي مستوطنات لم تحصل على موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، بيد أنها تتلقى خدمات من الدولة، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والأمن. وقد سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في معظم الحالات إلى “تنظيم” البؤر الاستيطانية – أي منحها الموافقة بعد قيامها على أرض الواقع. انظر “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
23 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population
24 “مراقبة الاستيطان، البيانات: السكان،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/population، و”مراقبة الاستيطان، البيانات: القدس،” منظمة السلام الآن، https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem.
25 نظام معلومات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، 22 أيلول/سبتمبر 2005، https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205164/#:~:text=Non%2DUN%20document-,Gaza%20disengagement%20%E2%80%93%20Special%20Envoy%20periodic%20report%20(Sept.,2005)%2FNon%2DUN%20document&text=The%20recent%20disengagement%20from%20the,swiftly%20and%20with%20minimal%20incident
26 انظر جيريمي شارب، “المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل،” خدمة أبحاث الكونغرس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.everycrsreport.com/files/2020-11-16_RL33222_14e84ea163b1e3a6ea037a815f455382b8102fad.pdf، 8.
27 قانون ليهي 22 قانون الولايات المتحدة §2378d و10 قانون الولايات المتحدة §2249e؛ و “حقائق قانون ليهي”، وزارة الخارجية الأميركية، 22 كانون الثاني/يناير 2019، https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/human-rights/leahy-law-fact-sheet/
28 انظر جيريمي شارب، “المساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل،” 28.
29 المحامي مايكل سفارد، “احتلال الضفة الغربية وجريمة الفصل العنصري: فتوى قانونية،” يش دين، حزيران/يونيو، 2020، https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+ENG.pdf
30 “الإسكوا تطلق تقريرًا حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري، “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، 15 آذار/مارس 2017. ملاحظة: سحبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقرير الإسكوا بُعيد إصداره عقبَ إدانة وضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل. انظر “استقالات رسمية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة بعد سحب تقرير ’الفصل العنصري‘ في إسرائيل،” رويترز، 17 آذار/مارس 2017، https://www.reuters.com/article/us-un-israel-report-resignation-idUSKBN16O24X
31 “نظام السيادة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: هذا فصل عنصري، “بتسليم، 12 كانون الثاني/يناير 2021، https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
32 انظر لويزا بلانشفيلد “التمويل الأميركي لمنظومة الأمم المتحدة: نظرة عامة وقضايا سياسات مختارة،” خدمة أبحاث الكونغرس، R45206، النسخة المحدثة 4، الجدول 5، 25 نيسان/أبريل 2018، 16. على سبيل المثال، حجبت الولايات المتحدة منذ الثمانينيات حصة متناسبة من الاشتراكات المقدرة في الميزانية العادية للأمم المتحدة لأنشطة أو برامج مختارة تتعلق بالفلسطينيين (القسم 114 من PL 98-164). انظر أيضًا: Gardiner Harris، “Trump Administration Withdraws US from UN Human Rights Council،” New York Times، June 19، 2018، https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel- الفلسطينيون؛ وجيم زانوتي، “الفلسطينيون: الخلفية والعلاقات الأميركية”، خدمة أبحاث الكونغرس، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، 17، https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34074/45.
33 لورا كيلي، “بومبيو يَعد بحماية الشركات الأميركية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل”، هيل، 2 آذار/مارس 2020، https://thehill.com/policy/international/485581-pompeo-promises-to-protect-us-businesses-in-israeli-controlled-west-bank.
34 نوا لا نداو، “بومبيو يهدد باستهداف المحكمة الجنائية الدولية ’الفاسدة‘ بسبب تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية والأميركية،” هآرتس، 2 حزيران/يونيو 2020، https://www.haaretz.com/us-news/.premium-pompeo-u-s-to-target-corrupt-world-court-over-israel-u-s-war-crimes-probe-1.8889873؛ وماثيو لي، “عقوبات أميركية جديدة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومساعده،” أسوشيتد برس، 2 أيلول/سبتمبر 2020، https://apnews.com/article/ec6fc680118ec01d01abe0173870e371.
35 “ألمانيا وبلدان أخرى لن تعترف بالضم الإسرائيلي”، دويتشه فيله، 7 تموز/يوليو 2020، https://www.dw.com/en/germany-others-would-not-recognize-israeli-annexation/a-54079952؛ وباراك رافيد، “سبق صحفي: ’مجموعة ميونخ‘ تقدم مقترحات جديدة لإسرائيل وفلسطين،” Axios، 10 شباط/فبراير 2021، https://www.axios.com/munich-group-israel-palestine-proposals-biden-277ef669-830d-49cf-9e12-fdb22b6f1133.html.
36 اتفاقيات أبراهام للسلام: معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل،” الموقعة في 15 أيلول/سبتمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/ 09 / UAE_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-September-2020-508.pdf.
37 “اتفاقيات أبراهام: إعلان سلام وتعاون وعلاقات دبلوماسية وودية بناءة بين البحرين وإسرائيل،” الموقعة في 15 أيلول/سبتمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf
38 “إعلان مشترك: المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل” تم التوقيع عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco-Israel.pdf
39 لا بد من الإشارة إلى أن السودان لم يوقع حتى الآن على اتفاقية رسمية مع إسرائيل على الرغم من إعلانه عزمه على تطبيع العلاقات في تشرين الأول/أكتوبر 2020. انظر “هل سيتم إلغاء اتفاقية تطبيع السودان مع إسرائيل؟”، البوابة، 22 شباط/فبراير 2021، https://www.albawaba.com/news/will-sudans-normalization-accord-israel-be-scrapped-1412675؛ وإعلان اتفاقيات أبراهام غير المؤرخ الذي وقعه السودان والذي يشير إلى دعمه لاتفاقيات أبراهام لكنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية أو يدعو إلى فتح مكاتب دبلوماسية، https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01 /Sudan-AA.pdf
40 أليكس وارد، “شرح المعركة حول صفقة الأسلحة الضخمة لترامب مع الإمارات،” فوكس، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020، https://www.vox.com/2020/12/1/21755390/trump-uae-f35-israel-weapons-sale؛ ومارك مازيتي، “الإدارة تقترح صفقة أسلحة للإمارات العربية المتحدة، لكن البعض في الكونغرس يعترض منذ الآن،” نيويورك تايمز، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، https://www.nytimes.com/2020/11/10/world/middleeast/weapons -trump-pompeo-emirates.html.
End of document
مركز مالكوم-كير-كارنيغي للشرق الأوسط
———————-
مع خطاب الضحية وضد خطاب النصر/ سمير الزبن
في قضايا الاستعمار والتحرّر الوطني، هناك مُستعمِر ومُستعمَر، ضحية وجلاد، معتدٍ ومعتدى عليه، ظالم ومظلوم. وبالتأكيد، هما ليستا قوتين متساويتين على طرفي جبهة حرب، تخوضان حربا فيها منتصر ومهزوم. تحديد الأساس المكون للصراع، وموقع الأطراف المتصارعة فيه، هو الذي يحدد طبيعة الخطاب السياسي الذي يحتاج إليه الطرف الذي يخوض الصراع، وتحديدًا عندما يكون هذا الطرف هو الضحية. وحتى لا يبقى الكلام في المجرّد والنظري، يمكن تحديد الصراع على الأرض الفلسطينية بوصفه صراعًا بين استعمار استيطاني اقتلاعي (وإجلائي) وشعب شُرّد الجزء الأكبر منه في حرب 1948 التي احتل خلالها الجزء الأساسي من الوطن الفلسطيني، وبنى عليه دولة إسرائيل. ولم يكتفِ المعتدي بذلك، بل عاد واحتل ما تبقى من فلسطين، فخضع الجزء الآخر للاحتلال في حرب 1967، إضافة إلى أجزاء من أراضٍ عربية أخرى. في هذا الصراع الممتد منذ أكثر من قرن، ليس من الصعب تحديد الضحية والجلاد. ولأن الفلسطينيين يشغلون موقع الضحية في هذا الصراع بامتياز، وبالتالي خطابهم خطاب تحرّر وطني، وهو ما يتطلب التعامل مع الصراع على هذا الأساس، بمعنى أن الجريمة الإسرائيلية واقعةٌ على الفلسطينيين بمجرّد وقوعهم تحت الاحتلال وخسارة الجزء الأكبر من وطنهم التاريخي. وهذا ما يمنح الفلسطينيين الحق في النضال من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم بأنفسهم، متحرّرين من الإسرائيليين. لأن القضية الفلسطينية ليست قضية تحرّر وطني عادية، بتركيبها المعقد، وعدوها ذي الطبيعة الاستثنائية، وكونها آخر قضية تحرر وطني، بعد إنجاز دول العالم استقلالها الوطني، في وقتٍ تنكر إسرائيل على الفلسطينيين أقل الحقوق، مع الاحتفاظ بتحكّمها كمحتل بحياة الفلسطينيين، حتى بعد انسحابها نظريًا من أرضهم، كما جرى ويجري مع قطاع غزة بعد أكثر من 16 عامًا على الانسحاب منه.
تغيب بديهيات الصراع هذه في لحظات الحماس التي تسعى إلى تصوير الواقع على غير حقيقته، ومنح النفس موقعا وقوة غير موجودين في الواقع، إنما هي رغباتٌ تُسقط على واقع متعب ومحطم، لا تخدم القضية. وفي مثل هذه اللحظات، يأتي الخطاب الشعبوي، ويرفع من وتيرته عاليًا، ليسوق وهمًا عند الضحايا أنهم مساوون لعدوهم في القدرة على الردع وإيقاع الأذى بالعدو، كما كان شعار “توازن الرعب” القديم الذي أطلقه خالد مشعل عندما شغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أو الاحتفال بالنصر بالجلوس على كنبة فوق الخراب الذي أحدثه القصف الإسرائيلي أخيرا على قطاع غزة، كما فعل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.
لا أرغب في أن أكون ضد المزاج العام الذي يبحث عن إنجازٍ ما يمنحه الأمل، لكن الخطاب الشعبوي لا يمنح الأمل بقدر ما يُسوّق الوهم. خطاب الانتصار شعبوي بامتياز، ولا أعتقد أن هذا النوع من الخطاب يناسب صراع الضحية مع جلادٍ يرتدي ثوب الحمل، كما هو حال الصراع مع إسرائيل.
اختلال ميزان القوى الفادح لمصلحة إسرائيل يجب ألا يثني الفلسطينيين في صراعهم معها. وليس للسلاح الدور الحاسم في الصراعات الممتدّة، والتي تتعلق بحقوق البشر ومحاولة سحقها بالقوة العارية للسلاح، فهناك حدودٌ لاستخدام السلاح لإنجاز الأهداف السياسية، وفي صراعٍ مركّبٍ ومعقد مثل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، من الممكن تحويل السلاح إلى عبء على صاحبه، أو تحييده في الصراع إلى حد كبير، ومنع إسرائيل من استخدامه بالطريقة التدميرية التي شهدناها في الحروب على قطاع غزة. ولنا في الانتفاضة الأولى دروسٌ وعبر في هذا السياق. طبعًا ليس المطلوب استنساخ التجربة السابقة، لأن التجارب يستفاد منها ولا تتكرّر، والتكرار يحولها إلى سخرية. وهذا لا يعني عدم استخدام الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال، لكن من المهم كيف ومتى؟ ومتى يكون أسلوبًا مفيدًا، وليس أسلوبًا يلحق الضرر بقضيتي. وبالتالي، على وسائل النضال التي تستخدمها الضحية أن تتناسب مع خطابها السياسي بوصفها ضحية.
من هنا، يجب إعادة النظر في تموقع أطراف الصراع في الخريطة الصراعية، بمعنى، ليست صحيحة الصورة التي تعطيها “حماس” للصراع، أنها بين طرفين، وأنّ الحركة ندٌّ لإسرائيل قادر على إيقاع الهزيمة بها. يناسب هذا الخطاب إسرائيل، بتصوير الصراع بين طرفين متساويين، بل أكثر من ذلك، تصوير ذاتها الطرف المعتدى عليه، والذي يدافع عن نفسه. في الوقت الذي تشكل اعتداءاتها على غزّة عملية قتل وتدمير ممنهجة لشعبٍ أعزل، يدافع عن نفسه بالوسائل المتاحة، مقابل عدوانية منفلتة من عقالها، تخرس سلطات العالم الرسمية ودولها أمامها.
كان مقدّرًا للهبّة الشعبية أن تتطوّر، أو أن تكون حلقةً في سلسلة حلقاتٍ نضاليةٍ في مواجهة شراسة الاحتلال وجرائمه، وهي أسلوبٌ مبدعٌ في الكفاح الشامل ضد إسرائيل وحّد التجمعات الفلسطينية، خصوصا داخل فلسطين التاريخية. ومن أفضل ما جاء به، أنه أسلوبٌ كفاحيٌّ ناجح بلا أب فصائلي. لم يكن من الصحيح الدخول على هذا الحراك، بتحويل اللحظة التاريخية إلى لحظة صدام مسلح، والبدء مباشرة في البحث عن اتفاق وقف إطلاق نار.
تقدّم الهبّة الشعبية في مواجهة الاعتداءات الاستيطانية المحمية من السلطة في إسرائيل في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، درسًا ثمينًا في اجتراح آليات نضالٍ في مواجهة إسرائيل، قادرةٍ على تأسيس الصراع، المرّة بعد الأخرى، على مكوناته الأساسية التي سيُحسم فيها الصراع، صراع الضحية والجلاد. فهذا أكثر ما تحتاجه القضية الفلسطينية اليوم، إطلاق الحريات الكفاحية للشعب الفلسطيني، وكفّ يد الفصائل عن احتكار العمل الوطني، واتخاذ فصيلٍ واحدٍ قراراتٍ مصيريةٍ، يضع كل الوضع الفلسطيني في سياق، مختلف مع سياق نضاله، (ولا أريد أن أقول متناقض).
ولّدت الهبّة الشعبية زخمًا أعطى الفلسطينيين أملًا أكبر من صواريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وما أتمناه، ألا يتم استخدام هذه الصواريخ في المرات المقبلة، بما يتناقض مع وسائل نضال شعبية فلسطينية واعدة. إننا بحاجةٍ لإعادة الصراع إلى مكوناته الأساسية أكثر من أي وقتٍ مضى، وهو وحده، وعبر الكفاح الشعبي المبدع، القادر على إنجاز ذلك. تستطيع الفصائل أن تُساعد في ذلك، كما أنها، للأسف، تستطيع أن تُجهضه.
العربي الجديد
————————-
حي الشيخ جراح ما زال مهدداً بالاخلاء..
أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أنه لن يقدم أي توصية للمحكمة العليا بشأن ملف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن مندلبليت أبلغ المحكمة العليا بقراره. وبحسب مصدر مقرب من المستشار القانوني، فإن المستوى السياسي في إسرائيل يعتقد “أن الدولة يجب ألا تتدخل”.
وأوضحت الصحيفة أن مندلبليت وجه رسالة إلى المحكمة كتب فيها أنه “في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات خلص المستشار القانوني إلى أنه لا يوجد مبرر ليظهر في المحكمة”.
وأمهلت المحكمة العليا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حتى الثلاثاء في 8 حزيران/يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.
ولتبرير عدم تقديم أي توصية للعليا، يعتقد مكتب مندلبليت أن “الوضع القانوني يميل إلى الإضرار بالعائلات الفلسطينية بطريقة لا يمكن منع الإخلاء”.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدم قبل أسابيع طلباً إلى المحكمة بتأجيل النظر في القضية بناءً على قرار سياسي، وذلك إثر الضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل لمنع عملية الترحيل. وأرجأت المحكمة الإسرائيلية في أيار/مايو، قرارها بشأن التماس قدمته 7 عائلات ضد إخلاء منازلها إلى حين الاستماع لرأي المستشار القانوني للحكومة.
وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إسرائيل من المضي في إجراءاتها في حي الشيخ جراح. وقال موقع “أكسيوس” الإخباري إن بلينكن نبّه القادة الإسرائيليين من أن المضي قدماً في سلسلة عمليات إخلاء بيوت العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية قد يؤدي إلى تجدد “التوتر والصراع والحرب”.
وأضاف بلينكن أن من المهم أيضاً تجنب الأعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي بقصد أو بغير قصد إلى اندلاع جولة أخرى من العنف، مشيراً إلى أنه سمع خلال زيارته للمنطقة من الإسرائيليين مباشرة، ومن حماس بشكل غير مباشر، أن الطرفين يريدان الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وتظاهر العشرات من أنصار السلام الإسرائيليين في حي الشيخ جراح مطالبين بإنهاء الاحتلال ووقف تهجير العائلات الفلسطينية، كما اعتصم صحافيون فلسطينيون على مدخل الحي للاحتجاج على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم.
من جهةً أخرى اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادره المستوطنون من جهة باب السلسلة. فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في مناطق من الضفة الغربية استهدفت أسرى محررين ومرشحاً في قائمة الجبهة الشعبية للانتخابات التشريعية الملغاة.
بدوره أعلن المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي عن إلغاء “مسيرة الأعلام” التي كانت مقررة الخميس في القدس المحتلة، وذلك في أعقاب توصيات الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بأن إجراء المسيرة من شأن أنه يؤدي إلى تصعيد بالقدس ويفجر الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعليقاً على قرار الشرطة، قال رئيس تحالف الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن “قرار الشرطة بمثابة رضوخ واستسلام مخزي للإرهاب وتهديدات حماس. المفتش العام للشرطة ليس بمقدوره حماية المتظاهرين في شوارع القدس بالأعلام الإسرائيلية، وغير قادر على حماية السكان اليهود في اللد والرملة وعكا، وهو الآن يجعل يحيى السنوار هو الذي يدير القدس”.
وأضاف سموتريتش أن “شعب إسرائيل حي ويستحق قيادة بديلة، قيادة قوية وأكثر تصميماً، وسيواصل مسيرته بفخر في شوارع القدس كلها وسيواصل الاستيطان في كل مكان فيها”.
—————————–
إسرائيل: جمهورية يعقوب قد تكرر مشهد الكابيتول
حازم الأمين – صحافي وكاتب لبناني
يونيو 8, 2021
إذا ما تكرر مشهد مبنى الكابيتول في واشنطن، بعد إعلان هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، في الكنيست الإسرائيلي أثناء تقديم نفتالي بنيت تشكيلته الحكومية، وهو ما توقعه جنرال في الشرطة الإسرائيلية، فإن العالم سيتيقن أن ترامب لم يكن عارضاً طارئاً يمكن تجاوزه ما أن يخسر الانتخابات.
ما وجه جاكوب، المستوطن الذي غزا حي الشيخ جراح، سوى امتداد لوجوه الرجال البيض الذين حطموا قاعة الكابيتول في ذلك اليوم الحالك في حياة أميركا. فالسنوات الأربع التي أمضاها الرجل في البيت الأبيض كادت تأتي على قيم دأب العالم على تثبيتها على مدى قرون.
احتمال أن يتكرر المشهد في الكنيست الإسرائيلي ليس ضئيلاً في ظل خطاب بنيامين نتانياهو التكفيري، والذي اتهم فيه بنيت بعبارات لا تقل سوقية عن تلك التي ساقها دونالد ترامب بحق جو بايدن في ذلك الوقت. كل العناصر متوافرة لأن يتكرر المشهد. رجل شعبوي وخطاب تعبئة لا يقيم وزناً لشيء سوى لمحاولة تفادي الخسارة، واحتقان سياسي بعد الحرب على غزة، وقطعان من مستوطنين جشعين ولاهثين وراء منزل يقتنصونه من أصحابه، وخسارة المنصب بالنسبة إلى الرئيس الخائب تعني احتمال مثوله أمام المحكمة ودخوله السجن.
وإسرائيل أقل حصانة من الولايات المتحدة من الحمى الترامبية، ذاك أن واشنطن أصيبت فيها على وقع توترات داخلية لا يتعدى عمرها عمر ولاية ترامب، أما تل أبيب، فمنذ دحرها اليسار، ومباشرتها الحرب على اتفاقيات أوسلو، وقتلها إسحاق رابين، وهي تؤسس للوعي “الجاكوبي”. وما نتانياهو إلا أحد عوارض هذه الحمى، وبنيت نفسه ليس بعيداً منه، فهو يريد إسرائيل الكبرى وتعزيز الاستيطان، ويريد القدس، كل القدس. وبهذا المعنى بنيت ليس تجاوزاً لنتانياهو، إنما امتداد له وتجديد لخطابه.
ما وجه جاكوب، المستوطن الذي غزا حي الشيخ جراح، سوى امتداد لوجوه الرجال البيض الذين حطموا قاعة الكابيتول في ذلك اليوم الحالك في حياة أميركا.
إسرائيل اليوم تمر بمرحلة عصيبة فعلاً، والاستجابة الدولية النادرة لمشهد الضحية الفلسطينية خلال مواجهات الشيخ جراح وحرب غزة، ستلاقي مزيداً من الأصداء في ضوء تكريس جاكوب صورته بوصفه الإسرائيلي العادي، وبوصف وظيفته كمستوطن تفوق بأهميتها وظيفة ابن تل أبيب بعدما فقد الأخير قيمته السياسية. وإذا ما تكرر مشهد الكابيتول في تل أبيب سيتسارع المسار الانحداري لما تمثله الدولة العبرية للعالم الغربي.
ويبدو أن إسرائيل لم تلتقط بعد حقيقة أن العالم باشر أعمال تفكيك الإرث الترامبي. موقف واشنطن خلال حرب غزة كان مؤشراً على أن ثمة فرصة للثأر من رجل ترامب الأول في الشرق الأوسط، أي بنيامين نتانياهو. وترامب “الخارج” لا يقل خطراً على أميركا من ترامب “الداخل”. عملية التفكيك لن تقتصر على استئناف مفوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني. فلنراقب ما يحصل في تركيا، وبداية تبدد أحلام رجب طيب أردوغان بالبقاء في السلطة، ولنراقب أيضاً الفتور في العلاقة بين واشنطن ودول الخليج العربي.
نتانياهو ليس بمنأى عن هذا المسار الانتقامي، لكن إسرائيل أمام مأزق آخر يتمثل في جاكوب، ذاك أن الأخير هو المواطن في حكومة بنيت أيضاً، ورئيس الحكومة العتيد لا يملك أفقاً آخر يقترحه على العالم، والعلاقة “الخاصة” بين إسرائيل وبين العالم بدأت فعلاً تتعرض لاهتزازات وأسئلة، وبدأت أجيال جديدة تفقد قناعتها بهذه العلاقة.
دولة المستوطنين ستواصل مهمتها في ظل الحكومة الجديدة، وبنيت ليس لديه شيء مختلف ليعرضه على الشريك الفلسطيني، هذا في وقت بدأنا نلتقط مؤشرات مختلفة لدى هذا الشريك. لدينا جيل فلسطيني جديد عابر للخط الأخضر، ولدينا دور مختلف لمصر وموقع متحرك لـ”حماس”، والأهم من هذا كله، رأي عام عالمي قابل للتوظيف في حال استطاع الفلسطينيون صياغة شروط عودتهم إلى حل الدولتين. المهمة الفلسطينية ليست سهلة، لا بل هي شديدة التعقيد، ولكن دونها مزيد من تقهقر القضية.
درج
———————–
====================