نفي الآخر منهجًا للعمل السياسي!/ حسان الأسود
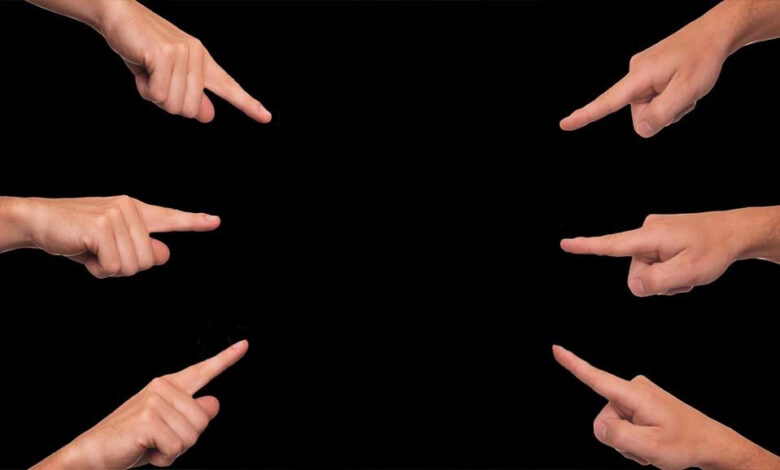
يبدو العنوان مثيرًا، إذا ما رجعنا إلى أساسيات الفكر السياسي الحديث، فلم يقم العمل السياسي على مبدأ الإقصاء، بل على مبدأ المشاركة والتنافس من خلال برامج تقدّمها الأحزاب لجمهور الناخبين. فمنذ بدء ترسّخ مفهوم الدولة، ومنذ دخول الجماهير في المجال العمومي، بعد أن كان ذلك حكرًا على فئات محددة من الطبقات العليا للمجتمع، صار الحُكم -ولو نظريًا- جزءًا من عملية تشاركية كبرى، يُسهم فيها المواطنون جميعًا. تعتمد العملية السياسية بشكل رئيس على تداول السلطة سلميًا بين الأحزاب، من خلال انتخابات دورية، وهذا يفترض قبول الجميع بمبدأ الأقلية والأكثرية السياسية، أي الفئة الحاصلة على أغلبية أصوات الناخبين، والفئة التي لم تتمكن من ذلك.
يفترض هذا المبدأ الأساسي مبدأ ثانيًا يتعلّق باحترام نتائج الانتخابات، فلا يمكن للأقلية الاحتجاج بأصوات ناخبيها لتخرج عن قواعد العمل السياسي، بل عليها أن تمارس معارضتها من خلال الأدوات الدستورية الممنوحة لها، أي من خلال الكتل البرلمانية، ومن خلال الصحافة والنقابات وغيرها من الاتحادات والتشكيلات المدنية الأخرى القادرة على التأثير في سياسات الحكومة. هذا القبول بالنتائج وهذا الاحترام للقواعد يعنيان -من حيث النتيجة- القبول بالآخر، وهنا يكون الخلاف مع الآخر/ المعارضة، ليس على اقتسام البلد، بل على طريقة إدارتها أو طريقة حكمها، ضمن القواعد العامة التي حددتها سلفًا نصوص العقد الاجتماعي، المتمثلة بالدستور الناظم لأسس تشكيل الدولة ونظامها السياسي، وما يتبعه من أنظمة اجتماعية واقتصادية وثقافية.
كل هذه النقاط التي تعدّ أساسيات في الدولة الحديثة بل بديهيات لا يُتحدّث بها، لا تحظى بذلك الحضور والقبول في المجتمعات المضطربة؛ ففي أنظمة الحكم الاستبدادي يتخلّف المبدأ الأساسي الأول، ألا وهو تداول السلطة، ويصبح عمل جميع مؤسسات الدولة منصبًّا على تأبيد حكم الفرد أو المجموعة الحاكمة، سواءٌ بليّ أعناق الدساتير والقوانين، أو بترهيب المجتمع من محاولات الخروج إلى الشارع، بعد أن سدّت أمام أفراده وسائل العمل الديمقراطي، في قاعات البرلمان المخصصة أساسًا لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرّة.
كذلك لا يكون هناك أي توافق على هذه الأساسيات في ظلّ غياب الدولة ذاتها، كما الحال عند اندلاع الثورات الشعبية أو الحروب الأهلية. هنا يصبح الخلاف ليس بين فرقاء يحترمون بعضهم على إدارة دولة ناجزة من خلال مؤسسات موجودة، بل يصبح الصراع تناحريًا بين أعداء يحاول كلّ منهم القضاء على الآخر، للاستئثار بالدولة كاملة. هذا ما تقوله التجربة العامّة للشعوب التي لم تتمكن من إنجاز استحقاق بناء الهويّة الوطنية بشكل نهائي. هكذا يأخذ الصراع شكل التناحر بين قوى مجتمعية تستند إلى مرجعيات ما قبل وطنية كالقبيلة والطائفة والمذهب، أو مرجعيات ما فوق وطنية كالدين والقومية. في هذه الحال، يصبح الهدف من الصراع ليس التشارك في إدارة الدولة ومواردها، بل الاستئثار بها كاملة، ولا يتمّ ذلك إلا بنفي الآخر وإفنائه نهائيًا.
بالعودة إلى الواقع السوري المشخّص، نجد أنّنا انقسمنا إلى طوائف وقوميات وشيع وأديان ومناطق، بمجرّد أن اندلعت الثورة السورية. لم يكن هناك اتفاق على تعريف سورية ذاتها، ولا على معايير الانتماء إليها. لم يكن باستطاعة أحدٍ أن يعرّف نفسه كسوري بحت من دون إضافات أخرى، فكانت صفة عربي أو كردي أو تركماني أو شركسي أو أرمني أو آشوري، ملحقة بأي تعريف، وبعض التعريفات أخذت بعدًا آخر لتصف بتحديد أكبر هذا السوري، ما بين مسلم ومسيحي، ثم بين سنّي ودرزي وشيعي وعلوي، وحتى حوراني وشامي وحمصي وحلبي وإدلبي.. إلخ.
هذا التمايز ما قبل الوطني لم يكن وليد فترة حكم العسكر فقط، بل هو ممتدّ إلى ما قبل ذلك بقرون عديدة، فالدولة العثمانية التي ابتدأت فيها محاولات الإصلاح الإداري، منذ مرحلة تشريع التنظيمات في بدايات القرن التاسع عشر، تحت تأثير الاحتكاك بالدول الأوروبية وحضارتها المتألّقة، لم تتمكن من إنجاز نهضتها التشريعية وتحويلها إلى واقع معيش سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وليس الآن مجال بحث أسباب تعثّر هذه المحاولة، لكن يمكن القول باختصار شديد إنها نتجت عن تداخل عوامل كثيرة، بعضها داخلي يتعلق ببنية المجتمعات المحكومة من قبلها، وبعضها الآخر خارجي يتعلق بتدخل الدول الأوروبية. لم يُتح لفكرة المواطنة التجذّر في بنية المجتمع وفي صلب العقيدة المؤسسية للسلطنة العثمانية، وهذا انسحب بدوره على جميع مؤسسات الدول العربية التي نشأت بعد الانفصال عنها، وكذلك بقيت بنى مجتمعاتها رافضة لهذا التحوّل غير المكتمل.
“تتيح آلية إنتاج الهُويّة المشتركة في العصر الحديث خلق إطار مشترك للمقارنة بين المنتمين إليه، والتطلّع إلى التمايز عن جماعات أخرى. وغالبًا ما يتجاوز الباحثون الذين يكتفون بترديد فكرة صحيحة، مفادها أنّ الهوية علاقة اجتماعية وبنية ثقافية مصنوعة، هذه الوظيفة الاجتماعية المهمة للهوية، والتي تفسّر بعض عوامل التعلّق بها. ويتجاوز هذا حتى الآليات النفسية لصنع الهوية في العصر الحديث، والمتلخّصة في مسألة صياغة الذات الفردية في مواجهة الآخر. سواء من خلال (نحن) جماعية أم بالتمايز عنها”[1].
لم يتشكّل هذا الإطار المشترك بين السوريين على أساس انتمائهم للجماعة الوطنية الموحّدة، بل كان على أسس أخرى أضيق قليلًا، كالطائفة والمنطقة، أو أوسع قليلًا كالقومية والدين. فالفترة التي توصف -تجاوزًا- بأنها فترة الحياة السياسية الديمقراطية في تاريخ سورية، لم تكن سوى فترة نضال ضدّ السيطرة الاستعمارية الفرنسية، ثم فترة عدم استقرار بسبب الانقلابات المتكررة، منذ أول انقلاب قاده حسني الزعيم عام تسعة وأربعين حتى سيطرة حافظ الأسد على السلطة رسميًا ونهائيًا عام سبعين. وفي هاتين الفترتين لم يكن بالإمكان بناءُ الهويّة الوطنية، التي تحتاج بطبيعة الحال إلى أجواء مستقرّة يتبادل فيها أفراد الشعب وفئاته رؤيتهم لهذه الهوية المشتركة بكل حرية وأناة.
لقد كانت مسألة صياغة الذات الفردية في مواجهة الآخر، أو الـ (نحن) الجماعية، في مواجهة الـ (هُم) الجماعية أيضًا، مستندة إلى الإطار الممكن حينئذٍ، واختلفت طبيعة هذا الإطار ما بين ضيّقٍ فرضه الانتماء إلى القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، وما بين واسع فرضه الانتماء إلى القومية أو الدين، لكنها لم تكن الهويّة الوطنية العابرة للأديان والقوميات والطوائف قط. أمّا مرحلة الأسد وابنه من بعده، فقد كانت مرحلة تحطيم كلّ البنى السابقة بامتياز، لبناء مسخ لها، أي إعادة إنتاج التاريخ بصيغة مهزلة صارخة. وكان ما أنتجته هذه الحقبة نسخة مشوّهة للمسخ الأساسي الذي وُلد كجنين غير مكتمل ومشوّه أصلًا.
من هنا، يمكن قراءة تصريح أحد قادة الإخوان المسلمين، عن إمكانية التضحية بالوليد للحفاظ على سلامة الوالدة، في تقديمه لمصالح تركيا على مصالح سورية، انطلاقًا من أولوية الانتماء إلى الجماعة العابرة للوطنية، أي بسبب الانتماء إلى الرابطة الدينية. كذلك يمكننا قراءة تبعيّة الغالبية العظمى من القوى الكردية السورية لقيادة وتوجيهات حزب العمال الكردستاني التركي، وهو ذاته ما ينطبق على باقي المنصات السورية المعارضة، ومنها الائتلاف. لقد كانت الفصائل العسكرية خير مثال حيّ على ضياع البوصلة وفقدان الهويّة، وما شهدناه من تناحرٍ بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” كان كافيًا لإثبات ذلك، فحتى هذه الأرضية الدينية الجزئية الضيقة التي يفترض أنّ كلا الفصيلين انطلقا منها، لم تستطع أن توحّد هويتهما، على الرغم من محاصرتهما من قبل قوات الأسد خمسة أعوام متتالية، حصارًا كانت نتيجته موت الأهالي من الجوع، ومن ثمّ سقوط الغوطة، وضياع سلطتيهما الزائفتين.
سيبقى هذا حالنا، ما لم نستفد من تجاربنا المتراكمة. عشرة أعوام من الصراع التناحري بين قوى يفترض فيها أن توحّد جهودها للتخلّص من الاستبداد، فإذا بها تمارس استبدادًا وإقصاءً من نوع جديد. يجب أن تتغيّر هذه العقليّة، ويجب أن يختفي هذا المنهج الذي يعتبر السياسة هي ذاتها إلغاء الآخر، ويجب أن نبدأ منذ الآن عمليّة بناء الهويّة الوطنية، وحياكة ثوبها الذي لن يدفئنا غيره.
[1]– عزمي بشارة – الطائفة، الطائفية والطوائف المتخيلة – ص 223
مركز حرمون




