نهاية «فن السينما» وبداية سينما التقنية!/ عزيز الحدادي
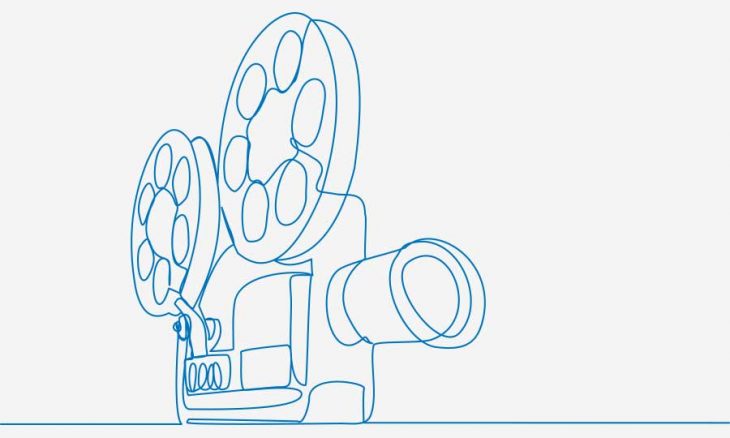
«بما أن التقنية تمحي الفن، والمونتاج هو المحو نفسه، فإن السينما أصبحت مهددة بالنهاية بشهادة الفلسفة». كل رؤية للأشياء، لا يمكن أن تكون إلا رؤية لجيل بكامله، ولعل رؤية الإنسانية، لا يمكن أن تختلف باختلاف الأمكنة، فالفيلم يشاهد في الوجود بالطريقة نفسها التي يسمع بها نغم الموسيقى، وجمالية اللوحة، إنه استطاع أن يبدع صوره، ويخلق منها القديسين ويجبرها على أن تكون جميلة ومحركة للابتهاج الإنساني، خاصة أن الفيلم لا يبحث عن اللغة السينمائية المعقدة التي تختفي وراء الفيلسوف. فعبقرية السينما خاصة بها تستثمرها في نشر المعرفة بالعالم، وتدعو الناس إلى تجاوز حدود وعيهم، بممارسة رياضة روحية، بل القيام بإصلاح أخطاء الروح، من خلال فتح المصالحة مع جمالية الفن وشاعرية الصورة، على الرغم من أنها تعتمد على إتوبيا حديثة، مع أن أنشتاين مثلا أضحى موضوع فكر السينما راهنيا في اليومي .
الواقع أن بعض النقاد اعتبروا السينما مجرد آلة تحتقر المسرح، الذي توقف عن الكلام أمام عنفها التجاري، لكن الحكمة تقول، إنها آلة عجيبة تتحكم في الزمان والمكان، كالمسرح والحياة اليومية، ولعل هذا بالذات ما سيجعلها تنجو من الهدم الهايدغري للتقنية، التي مزقت كينونة الإنسان. فالعمل السينمائي يتخذ أصالته من قدرته على تحريك الصورة في المكان بقوة الزمان، إنها وفرت دعما للنظرية الفيزيائية عن النسبية، كما تركها أنشتاين، وطورها المخرج إزنشتاين .
ففي هذا التفاعل بين التقنية والعلم، والتقنية والفن، يمكن صياغة إشكالية فلسفة السينما، وإذا كنا قد تعمدنا الانطلاق من موقف بعض الفلاسفة من تلك الأفلام التي شاهدوها، ورسمت في أعماقهم ذكريات جميلة، فإن هدفنا كان هو دفع الفلسفة إلى اختراع نفسها من جديد في عالم السينما، إذ ينبغي على آراء الفلسفة، وأسئلتها أن تصبح مرئية على شكل صور شاعرية تحقق إستطيقا الذات، بلغة نيتشويه .
لم يستطع هايدغر هدم التقنية، على الرغم من الأدلة البرهانية التي قدمها بصدد خطورة التقنية على الإنسان، لأنها بقدر ما تدعي إسعاده، بقدر ما تسعى إلى تدمير العالم الذي يعيش فيه، النووية لأكبر حجة على ذلك، بيد أن عدم قدرة هايدغر، لا يمكن اعتبارها فشلا لفيلسوف الوجود والزمان، في مواجهة التقنية التي تفتقد إلى ملكة الفكر، بل اصطدامه بالسينما التي تبدع بالتقنية وتحتمي وراء الفن وفلسفة الجمال، وبلغة الفلاسفة إنها تقنية بالعرض فنية بالذات، أو بالأحرى فنية بالماهية، تقنية بالظاهر. وبما أن هايدغر في محاضرته عن أصل العمل الفني يتساءل عن حقيقة العمل الفني، انطلاقا من الفنان، الذي يضع الحقيقة في العمل الفني: «هل ينبغي أن نعبث حين نقول: الفن هو وضع الحقيقة نفسها في العمل الفني، وليس تقليدا للواقع». هكذا يترك هايدغر العمل الفني يحدثه عن الحقيقة، خاصة أن الفيلسوف مطالب بتلبية نداء الحقيقة، إذا كان يرغب في السكن بجوار الوجود، ويتمتع بالسعادة، لأن من يريد أن يكون سعيدا لا بد له أن يتفلسف، ذلك أن الفلسفة تمس الإنسان في صميم ماهيته، لأنها لا تتناول بالبحث إلا ما يمس ماهيته .
فثمة حقيقة تنتظر من يلبي نداءها، كما لبى هايدغر نداء حقيقة العمل الفني، وهذه الحقيقة تؤرخ لتاريخها القصير في الفن السابع، من خلال مواجهتها مع أسئلة الوجود والزمان والحياة والموت، والجمال والبشاعة، والخير والشر، والسعادة والشقاء، وكل ذلك بسلاح التقنية والإستطيقا، من أجل حماية هويتها من الخراب: «فالسينما تبحث عن نفسها باستمرار، من خلال جدلية الحرية والفن، وقد تشكو من غياب لغة خاصة بها كباقي الفنون». فسؤالها يتوجه إلى جمالية الصورة، على عكس السؤال الفلسفي الذي يتوجه إلى ماهية الصورة في الوجود: «السؤال ما الوجود هو السؤال الذي تنحو نحوه الفلسفة، وتخفق المرة تلو المرة في الوصول إلى الإجابة عنه».
هكذا تكون الفلسفة تبحث عن نفسها في وجود الموجود، والسينما تبحث عن نفسها في جمالية الجمال، وتقنية التقنية، وبإعارة ماهية للفلسفة استطاعت أن تخترق أرواح الفلاسفة، ولذلك لا بد من الاعتراف بتفاعل السينما والفلسفة، وتثوير هذا التفاعل، لأنه بدلا من اختصار السينما في ظاهرة الحداثة، كما فعل التيار الفينومينولوجي الذي يتزعمه هايدغر وميرلوبنتي، ينبغي النظر إليها كعمل فني، ذلك أن السينما أكثر من أن تصبح مجرد انصهار للوعي في العالم، من خلال تناولها لزمنية الصورة، فهي تقاوم من أجل الحرية بسلاح الفن، لأنها لا تقدم فرسا جامدا على العكس، ماهيته الجامدة كما يفعل فن الرسم. فميرلوبونتي يقرأ السينما انطلاقا من قراءته لفن الرسم، ولذلك اختار لكتابه عنوانا غريبا: «العين والروح»، فما كان يهمه هو انصهار الوعي الإنساني في العالم، بعد تحريكه بالمحرك الأول، الذي وجده في فن الرسم، ولعل هذا العمل استمرار للعمل الذي قام به هايدغر في أصل العمل الفني، حين جعل من حذاء فان غوغ تعبيرا عن بشاعة النظام الرأسمالي، الذي احتقر الفلاح والعمل الفني في الآن نفسه، وأضحت الأعمال الفنية العظيمة في خطر، توضع مع البطاطس في المخازن المعتمة.
وسيرا وراء هذا الشغف الهايدغري بفن الرسم، استطاع ميرلوبونتي تأسيس إمبراطوريته الفنية، وأراد لها أن تعبر عن المعنى الفينومينولوجي للعالم: «فالفن، خاصة فن الرسم، قوته تظهر من خلال منديل الطاولة، الذي رسم ببراءة». فهذا المنديل البريء والمقدس، هو نفسه الذي تحكم في الرؤية الفلسفية للفن السابع عند برغسون، ولعل دلوز اعتبره رمزا للذاكرة التي تختزل زمن الصورة، وهو بالذات زمن السينما، وبالاعتماد على عبارة هوسرل الساحرة «العودة إلى الأشياء في ذاتها»، يكون الاتجاه الفينيمولوجي قد حقق الحلم الفلسفي الكبير الذي يتجلى في تلك الإقامة الشعرية في الفن، وما السينما إلا ذلك الفن السابع الذي انتشر بقوة في العالم. وأصبح يملي ذوقه على الأذواق المتعددة، فهل هناك انصهار للسينما؟ وهل بإمكانها أن تقلل من حجم النزعة النفعية للتقنية بواسطة براءة الفن؟ وبعبارة أخرى: هل استطاعت السينما أن تصمد أمام الهدم الهايدغري للتقنية؟ وما مكانتها في التيارات الفلسفية الحديثة والمعاصرة؟ سيأتي زمن السينما، حينما تؤسس فلسفة السينما من جديد.
كاتب مغربي
القدس العربي




