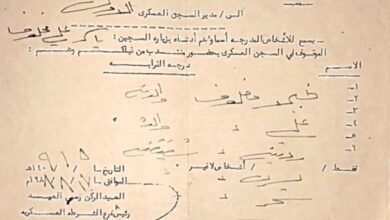أخاف أن أقف في شوارع دمشق وأرفع علم فلسطين/ ليلى إمام

ماذا يحدث في حي الشيخ جرّاح؟ كان سؤالاً مباغتاً وجهه إلي أحد الأصدقاء بعد مجموعة صور نشرتها على حساب الإنستغرام الخاص بي. يومها خجلت من أن أجيبه: “لا أعرف، لكنني مع فلسطين”. نحن لسنا في حاجة إلى نشرات الأخبار حين يكون الحدث خاصاً بفلسطين، ولا إلى المراسلين والمراسلات، ولا حتى إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نحن ننحاز إلى الحق كفعل بديهي. نحن مع أصحاب الأرض بالضرورة. مع ذلك، ذهبت بسرعة إلى محرك البحث غوغل لأجد إجابة. ثم أرسلت له مجموعة كلمات بذيئة لا أستخدمها في حياتي اليومية، أشتم فيها الاحتلال، وأباه، وأمه. وعددتها إجابة مقنعة وكافية.
في طفولتي المبكرة، وبينما كانت الصغيرات تحلمن بالفستان الأبيض، أو تلعبن لعبة الأميرات، كنت أحلم بالكوفية تلف عنقي، وأنا على إحدى جبهات الضفة الغربية، وكنت أقول بكل ثقة: “سأصبح مراسلة حربية، وسنحرر فلسطين”. كنت أتخيل نفسي أقاوم من فراشي، أبكي، أخاف من أسلحة الصهاينة، وأخاف من الحروب. وكان والدي يطمئن قلبي بقوله إن حربنا الوحيدة هي مع إسرائيل، ولن نجد أسلحة في الشارع السوري، وإن الانتفاضة ليست سوى فلسطينية، وهي انتفاضتنا جميعاً.
كبرت قليلاً، وعرفت أن الثورة والانتفاضة من حق الشعوب كلها؛ الشعوب البريئة من حكامها، وأن الشارع السوري سيكون خراباً، وإذا ما وجدنا أسلحة فيه، فلأن القصف سيكون جوياً. قبل ذلك، وطوال سنوات مظلمة، لم أعرف سوى حزب الله محوراً للمقاومة، ما دفعني في العاشرة من عمري إلى أن أتبرع بمصروفي كاملاً للحزب كي يحارب إسرائيل في جنوب لبنان عام 2006. علّقت في غرفتي صوراً لنصر الله مع علَم الحزب الذي وضعته فوق فراشي، لأن صواريخه ستحرر حيفا، لأعيش بعد ذلك في عقدة ذنب تكاد تقتلني لأنني ساهمت، ولو بمبلغ سخيف، بتكلفة صواريخ دمرت بلدات كاملة في سوريا.
خدّرني النظام السوري بمواضيع تعبيرية كتبتها عن أطفال الحجارة، ومجموعة فقرات في كتب القومية والتاريخ حفظتها عن ظهر قلب توحي بأن فلسطين بوصلتنا، وأننا قاب قوسين أو أدنى من تحريرها والجولان.
لكن بعد ذلك كله، كنت في حاجة إلى أن أكبر، وأعرف أن تلك الأقاويل والعهود كلها ليست إلا الكذبة الكبرى. عرفت إلى الحد الذي يجعلني اليوم خائفة من أقف في أي شارع من شوارع دمشق، وأرفع علم فسطين. فمن المؤكد أن أحد الفروع الأمنية سيرسل عناصره خلفي، ليستغل وقفة تضامنية مع فلسطين في تجديد بيعة بشار الأسد المقاوم والممانع، والذي في الحقيقة لم يحيّده عن التطبيع مع إسرائيل إلا سوء التوقيت.
بالمناسبة، هذا ما وجدته في إحدى الوقفات التضامنية التي قام بها شبان وشابات منذ فترة وجيزة أمام القصر العدلي في دمشق. كان عناصر الأمن يحوطون المكان، ليذكرونا أن لا شيء يحدث في دمشق إلا في عباءة القائد. وعلى الرغم من أن دعوات أُطلقت للخروج إلى حدود الجولان المحتل، لكن من منّا، نحن من حلمنا بالثورة السورية، يستطيع أن يخرج، ويرفع أعلام النظام، وصور بشار الأسد، ويقدّم له حملة انتخابية على طبق من ذهب؟
في طفولتي ومراهقتي، ما عرفته عن فلسطين كان كله عن طريق القنوات الفضائية السورية، التي تتعامل مع القضية كأنها القضية “السكسي”، التي يحشدون من خلالها تعاطف المجتمع وتأييده للنظام، مبررين تراجع البلاد بأننا مشغولون بالحرب مع إسرائيل، مع العلم أن حربنا كانت مجرد تحفظ على حق الرد؛ النكتة الأكثر شيوعاً في السنوات العشر الأخيرة.
بحكم أنني من الشمال السوري، لم يعش في مدينتي فلسطينيون، ولم أعرفهم كبشر من لحم ودم، بل عرفتهم كقضية، حتى اليوم الذي قررت فيه أن أكتب أول مقال صحافي ضد النظام السوري، واحتفاءً بمظاهرات خرجت في مدينة السويداء. كنت خائفة، لا بل مرعوبة. وبينما يداي ترتجفان، أرسلت مسودة المقال إلى رئيسة تحرير أحد المواقع مع طلب خجول مني بأن يُنشر باسم مستعار، فيأتيني الرد حنوناً رقيقاً يمسح الخوف كله من قلبي، بلهجة فلسطينية قرأتها بصوت كاتبتها: “بعدك بتيجي ع بالي، أكيد بنفع تنشري باسم مستعار”.
يومها كانت المرة الأولى التي أشعر فيها أنني صحافية، أقاوم من مكاني، وعلى طريقتي، وتعلمني فلسطين، مجدداً، المقاومة. يومها عرفت فلسطين، والمرأة الفلسطينية القوية والحنونة، التي تطبطب على كتفي بيد، لتنزع الخوف من صدري، وباليد الأخرى تحرر مقالاً لي ضد الديكتاتور، لتعلمني الكتابة والثورة.
اليوم في الداخل السوري، لا تذكّرنا انتفاضة فلسطين إلا بثورتنا، وبالحرية التي طالبنا بها منذ عشر سنوات، وقُتلنا واعتقلنا في سبيلها، وهُجّرنا من بيوتنا ليحتلها الروسي والإيراني وميليشيات حزب الله، ولا يبقى لنا إلا اللجوء. ها هي فلسطين التي علمتنا الثورة سابقاً، تنتفض من جديد. لكن العالم اليوم بات أصغر إلى درجة أن مواقع التواصل الاجتماعي راح يخيفها الضغط، والتضامن العالمي المنتشر، فبدأت تلجأ إلى قمع الجميع بالطرق الممكنة كلها. لن يستطيع الكيان الصهيوني هذه المرة تلميع صورته، ولم يعد في إمكانه التباهي بقبته الحديدية، فالحق خرق الحديد.
رصيف 22