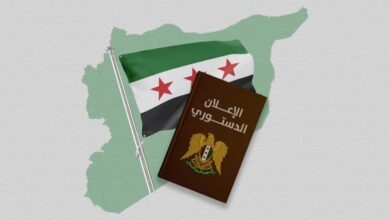الدرس التونسي -مقالات محتارة-

عزمي بشارة: الاستبداد بديل الديمقراطية في تونس
نشر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، تعليقاً في صفحته على “فيسبوك”، حول الأخطار التي تواجه الديمقراطية في تونس، بعد الانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد، وإعلانه أمس الإثنين جملة من القرارات الجديدة، وما تلا ذلك من مواقف أحزاب تونسية رافضة لخطوات سعيّد. وتوقف بشارة في تعليق بعنوان “الديمقراطية التونسية في مواجهة الشعبوية”، عند 10 نقاط أساسية، هي:
1. في أوج خيبة الذين “هرموا” منذ عام 2013 لأن آخر شمعة في حلكة “الاستثناء العربي” قد تنطفئ، توالت الأخبار عن مواقف النخبة التونسية السياسية والمدنية التي تراوحت بين رفض الانقلاب على الدستور والتحفّظ عليه (حذراً وليس تساهلاً). لقد عبّرت جميع الأحزاب السياسية، اليسارية والليبرالية (المحافظة وغير المحافظة) والإسلامية (ما خلا حزبين) عن موقف رافض من خطوات الرئيس. وتحفّظت المؤسسات المدنية الكبرى عليها، أو أبدت تحفظاتها. كما رفضت غالبية القانونيين التوانسة تفسيرات الرئيس القانونية للدستور.
2. في كتابي الأخير عن الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، وفي سياق تحليل نجاح الانتقال في تونس وفشله في مصر، أكدتُ اختلافي مع دراسات التحديث بشأن اعتبار معايير التحديث هي الفارق الرئيس بين النجاح والفشل، مشيراً إلى الفارق المهم في ثقافة النخب السياسية بين البلدين. في تونس أبدت النخب السياسية الرئيسية استعداداً للحوار في ظل الالتزام بالعملية الديمقراطية، في حين أنه في مصر فضّل بعضها التحالف مع عناصر من النظام القديم أو حتى مع الانقلاب العسكري ضد خصومها. ومنذ الأمس يؤكد رفض النخب التونسية الوازنة الانقلاب على الديمقراطية هذا الانطباع.
3. شكّلت الشعبوية بوصفها خطاباً ومزاجاً سياسياً تحدياً رئيساً للديمقراطية في تونس. ولم تتمكن الديمقراطية التونسية من التغلب عليه، بل أجّجته، بما في ذلك في خطاب الإعلام المتنافس على الإثارة واجتذاب المستمعين والمشاهدين (ولا سيما غير المسؤول وغير المهني منه) وفي التراشق بين الأحزاب في البرلمان (هكذا أدرّجهما من حيث المسؤولية أيضاً).
4. وكانت الطامة الكبرى بانتخاب رئيس من دون سجل مهني بارز أو نضالي أو سياسي، بل بسبب خطابه الشعبوي المقعر لا غير. (من المفارقات أن من يؤجج الخطاب الشعبوي ضد النخب السياسية والحزبية والثقافية في أوساط الجمهور هم عادة عناصر وأفراد من النخبة ذاتها، وذلك لأسباب أيديولوجية أو مصلحية أو وصولية، واللافت أنه غالباً ما يكون هؤلاء من الفاشلين في مجالهم المهني الحاقدين على زملائهم، ويحوّلون الحقد إلى غضب وخطاب سياسي انتقامي من النخبة عموماً).
التحديثات الحية
دعوات عربية ودولية للتهدئة والامتثال للدستور في تونس
5. يعاني الشعب التونسي من مشاكل اقتصادية عديدة زاد من حدّتها وجود توقعات كبرى من النظام الجديد، وأدت الخيبات في بعض الحالات إلى التوق إلى النظام القديم. ولم تتمكّن الديمقراطية التونسية من تلبية التوقعات وحل المشاكل بخطط وخطوات تنموية، ولا شك أن عجز الائتلافات الحاكمة، وأيضاً المماحكات الحزبية ورغبة المعارضة في إفشال أي ائتلاف أسهمت في ذلك. ولم تُتخذ خطوات لرفع العتبة الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان لتقليل عدد الكتل الصغيرة وتسهيل تشكيل الائتلافات وعمل الحكومات.
6. ظهرت الخيبة من البرلمان في تراجع نسب التصويت، وكذلك في التصويت في انتخابات الرئاسة لمرشح شعبوي تحوّل ضعفه (قلة خبرته السياسية) إلى قوة لأنه بدا وكأنه ليس سياسياً. لم يكتفِ هذا المرشح الذي أصبح رئيساً بالمجاهرة بعدم خبرته، بل أكد أنه لم يصوّت في أي انتخابات في تونس الديمقراطية. وهذا تعبير ليس فقط عن استخفاف بالديمقراطية، بل بقلة اهتمام بالمجال العام من طرف شخص رشّح نفسه للرئاسة، وشعور نفسي دفين أن لا أحد يستحق أن يمنحه صوته. وهذا بنيّة نفسية معادية للديمقراطية.
7. إن قيام سياسيين بالتحريض على السياسة هو من أهم علامات الشعبوية المعادية للديمقراطية. فلا ديمقراطية من دون سياسة وسياسيين. الديكتاتور هو أسوأ أنواع السياسيين لأنه الأكثر استخداماً للتآمر والأحابيل والعنف، ولكنه يدعي الترفع عن السياسة.
8. مهمة الساعة هي تعاون النخب السياسية والمدنية الوطنية التونسية على الرغم من الخلافات في مواجهة الأخطار المحدقة بالديمقراطية. وهذا يشمل مواجهة الشعبوية بفضح أهدافها الحقيقية وبمخاطبة الشعب والإجابة عن مخاوفه.
9. جميع الأنظمة السلطوية تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجميعها واجهت جائحة كورونا وغيرها. وتواجه الديمقراطيات (التي تبقى أكثر جاذبية فلم نسمع عن توانسة أو غيرهم يهاجرون للعيش في روسيا والصين وهنغاريا وبولندا فضلاً عن كوريا الشمالية) مصاعب اقتصادية واجتماعية، وبعضها استعان بالجيش في مواجهة الوباء، ولكن الجيش لم ينسَ، خلال تأدية المهام الاستثنائية، أن عليه الالتزام بالدستور. الديمقراطيات تواجه المشاكل في إطار النظام الديمقراطي.
10. الديمقراطية بحد ذاتها هي حل لآفة الطغيان والاستبداد وضمان لحقوق المواطن، وليست حلاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. فهذه وظيفة القوى السياسية والاجتماعية وسياسات القوى الحاكمة ومؤسسات الحكم، وذلك في إطار النظام الديمقراطي الذي يجب الحفاظ عليه لأن البديل هو الاستبداد.
العربي الجديد
—————————-
الدرس التونسي الجديد/ عمرو حمزاوي
حين يستقر، يمكن التنظيم الديمقراطي للدولة وللمجتمع المواطنات والمواطنين من المشاركة في الشأن العام فيظل ضمانات للحريات ولحقوق الإنسان ولكرامته ولتكافؤ الفرص وبحث مشروع عن المبادرة الفردية.
بالقطع وبالتحرر من المقاربة المثالية للديمقراطية، تتفاوت حظوظ الناس وتؤثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في درجات شعورهم بالحريات وحقوق الإنسان وممارستهم للمبادرة الفردية. إلا أن تمكين قطاعات تتسع باطراد يمثل قاعدة أساس للديمقراطية، ويقترن بها دوما التحرر من الخوف النابع إن من قمع الحكام للمحكومين أو من تراكم المظالم المجتمعية. وفي الكثير من الحالات، توفر الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية والمبادرة الفردية والتحرر من الخوف بيئة مساعدة تدفع بالدولة والمجتمع المعنيين إلى التنمية المستدامة والتقدم.
على الرغم من ذلك، يجافي الصواب الاعتقاد بأن القبول الشعبي للتنظيم الديمقراطي للدولة وللمجتمع يستند فقط إلى ضمانات الحقوق والحريات الشخصية والعامة التي تقر دستوريا وقانونيا وتفعل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. فبجانب ضمانات الحقوق والحريات، تدلل الخبرات التاريخية والمعاصرة للديمقراطيات على أن قبولها الشعبي يرتبط بأفضليتها مقارنة بالأنماط الأخرى للحكم ولإدارة الشأن العام فيما خص تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي. وعد الديمقراطية هو اقتران الحقوق والحريات بتحسن الأحوال المعيشية للمواطنات وللمواطنين وارتفاع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية التي يحصلون عليها وتمكينهم بتمايزاتهم من المشاركة في النشاط الاقتصادي على أساس من تكافؤ الفرص والمنافسة وضمان مشاركتهم في الحياة الاجتماعية وكذلك ممارستهم للشعائر الدينية في إطار من الحرية والمساواة والأمن.
وعد الديمقراطية والتحول الديمقراطي هو اقتران الإقرار الدستوري والقانوني للحقوق والحريات بتنامي التزام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والتزام الكيانات الجماعية غير الحكومية بسيادة القانون والسلمية ومحاربة الفساد واستغلال المنصب العام.
أما حين تخفق الديمقراطيات والمجتمعات الساعية إلى التحول الديمقراطي في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي، فإن حضور ضمانات الحقوق والحريات الشخصية والعامة لا يحول بين الناس وبين الاندفاع الجماعي نحو تأييد أنماط أخرى للحكم تبني قبولها الشعبي على وعد مضاد، إن باستعادة التنمية والتقدم كما فعلت الفاشيات الأوروبية والآسيوية في النصف الأول من القرن العشرين والحكومات الفاشية والعسكرية في أمريكا اللاتينية في نصفه الثاني أو بإنقاذ السلم الأهلي وبناء الدولة القوية وتحقيق التحرر الوطني كما فعلت نخب الاستقلال (عسكرية ومدنية) في العديد من الدول العربية والإفريقية في النصف الثاني من القرن العشرين أو بخليط من كل هذا ومعه الحنين إلى الحد الأدنى من الاستقرار الذي تذهب به دوما التحولات الديمقراطية في بداياتها والتخلص من قوى سياسية تختزل الحرية في صراعات حزبية لا تنتهي وفي تأجيج غير مسؤول للاستقطاب المجتمعي كما تدلل خيرات ما بعد الربيع العربي 2011.
وفي حالات أخرى، كالصين التي لم يتطور بها أبدا التنظيم الديمقراطي، تستجيب أغلبية مستقرة من الناس لمساومة جماعية جوهرها قضاء الدولة على الفقر وضمانها للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وللتنمية المستدامة وتخلي المجتمع، باستثناء مجموعات صغيرة من المفكرين والكتاب والصحافيين والحقوقيين وأساتذة الجامعات، عن المطالبة بالحقوق والحريات الشخصية والسياسية.
غير أن الإشكالية الكبرى هنا هي أن الخبرة التاريخية والمعاصرة لأنماط الحكم غير الديمقراطية تثبت عجزها عن تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي والحفاظ على الاستقلال الوطني على نحو مستقر وتدلل أيضا على تواتر زجها بدولها ومجتمعاتها إلى أتون أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تنتهي. وقد يستفيق الناس، وبعد اندفاعهم لتأييد التخلي عن الديمقراطية أو استبعادها من قاموس المرغوب به جماعيا على خسارتهم لكل شيء بغياب التنمية المستدامة والتقدم وانهيار ضمانات الحقوق والحريات. هكذا انتهت الفاشيات الأوروبية والآسيوية والحكومات العسكرية في أمريكا اللاتينية، وهكذا كان السجل التاريخي للعديد من نخب الاستقلال في الدول العربية والإفريقية.
ولم يبتعد عن خبرة فشل أنماط الحكم غير الديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة إلا دول كالصين لها خصوصية جلية ترتبط بالتاريخ والجغرافيا والمساحة والكثافة السكانية والموارد الطبيعية الهائلة، ودول مثل سنغافورة التي تبنت نموذجا تنمويا ناجحا عماده قيادة نخبة الحكم للقضاء على الفقر ونشر التعليم ومحاربة الفساد، ودول ذات ثروات طبيعية هائلة كالدول النفطية في الخليج.
يعني هذا، وأسجله اليوم والأزمة المجتمعية والسياسية الراهنة في تونس تدلل بجلاء على فقدان الناس للثقة في الآليات والإجراءات الديمقراطية بعد أن أمعنت قوى حزبية عديدة في اختزال الحرية في مماحكات واستقطاب وأهدرت بسوء إدارة بالغ حق المواطنات والمواطنين في النجاة صحيا واقتصاديا من جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد، يعني أن الأمل في ضمانات فعالة ومستقرة لحقوقنا وحرياتنا يظل معقودا على استعادة القبول الشعبي لبناء الديمقراطية كحل وتمكين آلياتها وإجراءاتها من إحداث مفاعيلها في المجتمع باتجاه التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي والدولة القوية العادلة دون انقطاعات.
يعني هذا أيضا ضرورة وجود نخب سياسية واقتصادية ومجتمعية قادرة على التفكير بواقعية في مسارات بناء الديمقراطية والحفاظ عليها وفي سبل حقيقية للحد من المماحكات والاستقطاب وتجنيب البلاد أخطار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، يعني هذا، أخيرا، حتمية الربط بين التحولات الديمقراطية المأمولة وبين الوعد بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي والربط دون استعلاء زائف بين المكتسبات الديمقراطية على أصعدة ضمانات الحقوق والحريات وبين مطالب الناس الحياتية ومحورها في بلادنا الفقيرة الخبز والدواء والأمن.
كاتب من مصر
القدس العربي
—————————–
هل يمكن إنقاذ الديمقراطية في تونس؟/ حسين عبد العزيز
لم تكن خطوة الرئيس قيس سعيّد مفاجئة للمراقبين للشأن التونسي، نظرا إلى خطواته الكثيرة في الفترة الماضية، وتعكس رؤية رجلٍ وجد في كرسي الرئاسة ضالّته للاستحواذ على كامل السلطة، غير مكترثٍ لمشكلات الديمقراطيات الناشئة، ومنها الديمقراطية التونسية، والتي لا يكون حلها إلا بمزيدٍ من العمل الديمقراطي والمؤسساتي والقانوني، وليس بتعطيل العمل السياسي بفعل غرائز نفسية أحلت النكاية والعناد محل الصبر المؤسساتي، ورغبة جامحة في الاستحواذ على كامل السلطات (تكليفه رئيس الحكومة ومحاولة إزاحته من خارج الأطر البرلمانية، رفضه استقبال الوزراء لتأدية القسم، رفضه إنشاء محكمة دستورية تعتبر ضرورية جدا في الديمقراطيات الناشئة، كجهة فصل قانوني ومؤسساتي للنزاعات، ويكون لها وحدها إمكانية تفسير مواد الدستور).
قد يكون لحركة النهضة والقوى السياسية الأخرى أخطاؤها خلال صيرورة الحكم، وهو أمر طبيعي في دولة ومجتمع يعاد هندسته على أسس مغايرة لأسس الحكم السابقة. ولكن تجاوز الأخطاء، إن كانت هي سبب المشكلات الداخلية، لا يكون بالانقلاب على الديمقراطية، وإنما يكون إما بالاحتكام إلى تسويات سياسية/ قانونية، أو باللجوء مجددا إلى الشارع الذي يملك الكلمة الفصل في صناديق الاقتراع.
أخطر ما في الأمر أن الجيش دخل في اللعبة السياسية، وانحاز لطرف على حساب الطرف الآخر، وهذه قد تشكّل تحولا مهما في الانقضاض على الديمقراطية وإرثها الوجيز في تونس. .. وعقودا، ظل الجيش التونسي، كمؤسسة عسكرية، محايدا تجاه السياسة، وكان من نتيجته في أثناء الثورة وقوفه مع الدولة وليس مع النظام، وهذه خصوصية تونسية يؤكّد عزمي بشارة عليها، حين قال “إن وجود جماعة وطنية تفهم نفسها على هذا المستوى كشعب في علاقة مع الدولة، وتتحوّل في خيال الفرد إلى جماعة يتخيّل أنه ينتمي إليها هو بالضبط ما يمكن من فصل الشعب عن النظام في لحظة الثورة، من دون أن ينقسم إلى جماعات، وإن البنية نفسها هي التي تمكّن الدولة من التضحية بالنظام والانفصال عنه دون أن تنهار، وتمثلت هذه الخطوة في تونس بحيادية الجيش”.
من الواضح أن الجيش التونسي لم يتحوّل بعد إلى مؤسسةٍ محترفة، فما منعه قبل عشر سنوات من الوقوف إلى جانب نظام بن علي، هو إدراكه المبكر أن الثورة ستنجح. أما تدخّله اليوم، فأسبابه غير معروفة، هل هي رغبة في العودة إلى المشاركة في الحكم، أم قناعته بمصداقية مطالب قيس سعيّد، أم قناعته بأن الوقوف إلى جانب طرفٍ سيؤدّي إلى إنهاء الأزمة السياسية المستفحلة؟
من الصعوبة بمكان الإجابة على هذه الأسئلة الآن. ولكن على المستوى النظري يصعب إعادة تكرار النموذج المصري عام 2013 في تونس، فلا وجود لمؤسسةٍ عسكريةٍ قوية متوغلة في الاقتصاد والمجتمع، ولا وجود لشخصيةٍ عسكريةٍ على رأس السلطة، كما كان الأمر مع عبد الفتاح السيسي في مصر.
تتطلب هذه اللحظة وعيا عاليا على مستوى النخب وعلى مستوى الشعب: بالنسبة للنخب، لن يكون أمامها إلا الأدوات المؤسساتية والسياسية لمواجهة الانقلاب، ومن الخطورة بمكان الاحتكام إلى سياسات الهوية أو إلى العمل المسلح، فهذان الأمران سيضعفان من مصداقيتهما في الشارع لصالح الرئيس سعيّد والجيش. وحتى لو وصل الأمر إلى الإقصاء التام، فلن يكون أمام القوى السياسية المقصاة إلا التماسك على يد واحدة، والاحتكام للشارع في العملية الانتخابية المقبلة. وبالنسبة للشارع، من المهم إجراء فصل بين الرغبات (والأمنيات) ما هو في صالح البلد، فليس التدهور الاقتصادي واستشراء الفساد والمحسوبية مرتبطا بهذا الفصيل أو ذاك، فقد علمتنا التجارب التاريخية أن المجتمع والدولة يدخلان بعد سقوط الاستبداد في مرحلةٍ انتقاليةٍ من سماتها الأساسية الاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتنشأ فيها شخصياتٌ سياسيةٌ وعسكريةٌ مغمورة، ليس لها أي تاريخ أو وزن محلي.
من المهم للتونسيين الإدراك أن الانقلاب على حركة النهضة وحلفائها ليس انقلابا على فصيل بعينه، بقدر ما هو انقلابٌ على الديمقراطية ذاتها. وفي حال نجح ذلك، ستكون العودة إلى الديمقراطية في غاية الصعوبة، والمثال المصري حاضر في الأذهان. وإذا كانت مصر تفتقد لطبقة وسطى قوية حاملة للمشروع الديمقراطي، فإن تونس تمتلك هذه الطبقة، وسيكون منوطا بها مواجهة الانقلاب السياسي ـ العسكري. ولذلك هناك فرصة لإنقاذ الديمقراطية التونسية.
العربي الجديد
——————————-
جمهورية!/ شوقي بن حسن
أن نصحو ذات 25 جويلية* (تموز/ يوليو) في تونس، فلا نجد الجمهورية.
إنه كابوس بلا شك. ومن حسن الحظّ أنه من شبه المستحيل أن يتحقّق.
أن نصحو ذات يوم في تونس، فنجد الجمهورية ممسوخة…
هذه صيغة كافكاوية لذات الكابوس.
لكنها قابلة للتحقّق… بل لعلّها متحقّقة بالفعل…
* ذكرى إعلان الجمهورية عام 1957 في تونس
■ ■ ■
ما يُطمئننا على النظام الجمهوري، في تونس، هو عدم وجود أفق لنظام بديل. لقد جرى تصفية المَلكية وأشكالها منذ عقود طويلة، بحسم وحزم وبساطة.
قد يقال أن الجمهورية كانت لعبة ميكيافيلية أوصلت بورقيبة إلى الحكم بصلاحيات واسعة.
لا ينفي ذلك أنها الخيار الأفضل، هل يتحرّك التاريخ دون هذه الحيل؟
لعله تأويل افترائيٌّ للتاريخ ضد بورقيبة. فلتونس نخبة متنوّرة لا شكّ وأنها طمحت إلى النموذج الجمهوري. للأسف لن نجد من يضع ذلك في سردية شاملة، ولكنه افتراض له مستندات صلبة.
ويمكن أيضاً ألا نطرح السؤال من أساسه: كيف وصلنا إلى الجمهورية؟
ما ينبغي أن يُطرح على مؤسّس الجمهورية هو ما فعله بها…
طوال ليالي الحكم الطويلة…
■ ■ ■
الجمهورية، إذ عدنا للقاموس، أو حتى للحس السليم وحده، هي نظام تكون فيه السلطة للشعب، للجمهور، للإرادة العامة. فهل كانت ذات يوم؟
يقول لنا الأصل اللاتيني Res Publica أن الجمهورية هي “الشيء العام”، الشأن العام بعبارة أكثر تداولاً.
بصياغة جان جاك روسو: “أن يحكم الشعب نفسه بنفسه”. إنها المثال السياسي الأعلى الذي ينبغي للمجتمعات أن تبلغه.
معظم دول الأرض تديرها أنظمة جمهورية، هل بهذه البساطة تتحقّق الجمهوريات؟
نعم
لكن باسم الجمهورية تقترف كل التحيّلات على الشعوب
يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال ممثّلين له
ماذا نقول حين يُنكر الشعب ممثّليه، فلا يتعرّف على نفسه فيهم؟
هل يتعلّق الأمر – رغم ذلك ـ بـ”جمهورية”؟
لعلّها أشباه جمهوريات نقضي حياتنا فيها
بعضها جمهوريات موز، كما يقول ذلك التعبير الكاريكاتيري
بعضها، وربما معظمها، جمهوريات منقوصة.
لكن هل يوجد عقل جماعيّ يفكّر في تجاوز نقصها؟
■ ■ ■
يمكن أن نقول: الجمهورية هي حكم الشعب.. والبقية تفاصيل
لكن ماذ لو كانت التفاصيل هي التي تعيق تحقّق الجمهورية؟
هناك فرضية يقوم عليها كل نظام جمهوري، وهي أن كل مواطن مشارك في الحكم.
هل يشعر المواطنون، كل المواطنين، بذلك؟
ألا يقف الممثلون أنفسهم حاجزاً دون ذلك؟
بل كل النخب… في كل مكان
هل توجد ندية بين المواطنين والقائمين على أجهزة الحكم؟
ليس الطبقة السياسية فحسب، بل حتى الطبقة البيروقراطية؟
بهذا المعنى، فإن المخوّل الوحيد كي يمنح صفة الجمهورية هو المواطن متى شعُر بأنه طرف في الحكم.
جرى تصعيد هذا المعنى ضمن خطاب قيس سعيّد في حملته الانتخابية في 2019
لعلّها كانت ورقة انتخابية ناجعة، لكن مقترحات تنفيذ هذه الفكرة ظلّت معلّقة، ثمّ تاهت الفكرة وذوت في مناورات الحياة اليومية للسياسيين
لا يخفى أن هناك صعوبة تاريخية في تجسيد مُثُل الجمهورية…
من الجيّد أن المفهوم بات مبذولاً للتداول، لكن أي معنى لفكرة رائجة ولا تثقب الجدران؟
■ ■ ■
في فرنسا، كانت الجمهورية نتاج تاريخ معقّد
كان لا بدّ من خيبات وانكسارات. جمهوريتان قصيرتا النفس من أجل نظام جمهوري راسخ يحكم منذ 1870
الفرنسيون باتوا يعتقدون أن الجمهورية فكرتُهم على الرغم من تاريخها البعيد، وجذورها الرومانية – الإيطالية المعروفة
يختم الرؤساء خطاباتهم بالقول: تحيا الجمهورية
إنها صانعة الهوية الفرنسية الجديدة، تماماً كما فعلت ذلك الملكية لقرون والإمبراطورية لعقود
تتلاحق الجمهوريات في فرنسا وترقيماتها (على عادة الملوك) وتتنافس في مراكمة الإنجازات لصالح البلاد
لكن ما سرّ عام 1870 الذي وطّد أقدام الجمهورية، ونقلها من حزب إلى إطار عام تتحرّك ضمنه كل الصراعات السياسية؟
لقد جاءت الجمهورية الفرنسية (الثالثة) بعد هزيمة عسكرية قاسية ضد ألمانيا. كان الخوف من انهيار “الحضارة الفرنسية” وراء الركون إلى هذه اليوتوبيا السياسية. لم يعد من الممكن الاطمئنان للرعاية الأبوية لإمبراطور أو ملك. لا بد من تسخير كل مقدّرات الشعب لإدارة الوطن.
حين وصل الجمهوريون لم يتورّعوا في قلع التطلّعات الملكية والإمبراطورية والفوضوية بعنف.
وحين استتبّ الأمر للجمهورية قرّرت أن تغزو المستقبل، وها قد نجحت في ذلك. فعلى مسافة قرن ونصف من الحكم الجمهوري في فرنسا لا بديل يبدو في الأفق إلا التنويعات الجمهورية
هذا الموقع حصّلته الجمهورية في زمن حكم الرئيس جول فيري الذي استثمر جهاز الدولة في اتجاهين: المدرسة (ضمان المستقبل) والاستعمار (ضمان تصريف معضلات المجتمع الفرنسي)
وإذا قلنا الاستعمار، فقد التقينا مجدّداً بتاريخنا، نحن في تونس أو في الجزائر والمغرب…
■ ■ ■
لم تصلنا الجمهورية عبر تاريخ طويل
وصلت منجّمة في عقول ذهبت للدراسة في فرنسا أو تأثّرت بأفكار فلاسفتها
ثم نبتت فجأة بعد الاستقلال
الجمهورية – في تاريخنا – أقرب إلى كونها حقنة
وقد تبيّن أن هذه الفكرة / الحقنة لا تحتاج إلى أرضية ملائمة كي تعيش..
تستطيع أن تعمل بغض النظر عن مراعاتها للمثال الجمهوري
يبدو أن الجميع قد اطمأن لذلك.
ربما بسبب هذه الطمأنينة قلما نفكّر في الجمهورية
■ ■ ■
صدر منذ سنوات بالفرنسية “القاموس النقدي للجمهورية”، وفيه يقف المشاركون على إشكاليات سنتعرّف عليها بسهولة في واقعنا العربي. حيث أن الفكرة المثالية لا تعصم من الانحرافات، لكن ما ينقذ النظام الجمهوري في كل مرة هو أنه يتغذّى من قائمة مُثل يعلنها: تداول السلطة، المواطنة، احترام المؤسسات واستمرارها، العدالة، ضمان الحريات…
ليست الجمهورية مجرّد نظام من المؤسسات، إنها قبل ذلك نظام رمزيّ، ويؤكّد “القاموس النقدي” أن سمة الجمهورية اشتغالها على الأسطورة الجماعية، وهو ما يتجلّى في المعمار والأناشيد والأوسمة والأعياد المدنية والجنازات الرسمية.
كما تتميّز الجمهورية بالمشاريع الكبرى… مشاريع بحجم شعب.. والشعب لا يختزل إلا في جمهورية.
وما لم تملك أمّة آليات تشغيل النظام الرمزي فلا معنى للجمهورية فيها..
■ ■ ■
هكذا
فالجمهورية ليست مهدّدة كنظام. إنها مهدّدة كفكرة محرّكة للهمم
ما يهدّد لجمهورية هو فقدانها للمعنى
وحين تكون فاقدة للمعنى لا يعني ذلك أنها لن تشتغل كسلطة
أشياء كثيرة فاقدة للمعنى وللشرعية تتحرّك في حياتنا…
بعضها ضروري، ولا بدّ من إعادة شحنه بالمعنى والأحلام والقيم.
العربي الجديد
—————————–
قيس سعيّد يجمد عمل البرلمان التونسي ويقيل الحكومة
—————————–
تونس على ضفاف “السيساوية”: كيف نتجنّب السيناريو الأسود؟/ إيلي عبدو
المعضلة في تونس حالياً، هي فشل في إدارة الفترة الانتقالية وقتلها بأولوية التوافق، وانفصال أحوال السياسة عن أحوال الناس، وظهور شعبوي سلطوي يقتنص الفرص للانقضاض على التجربة الدستورية الهشة أصلاً.
لا تزال الصورة غير واضحة في تونس، عقب قرارات الرئيس قيس سعيّد، القاضية بعزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، فالجيش الذي منع فعلاً نواب الشعب على رأسهم رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان، بدأ منحازاً لسعيّد، غير أن هذا الانحياز يصعب تحديد مداه والجزم بأن يكون مطلقاً. كما لا يبدو واضحاً ما إذا كان سعيّد يسعى إلى إقصاء الطبقة السياسية كلها، أم يريد تصفية حركة “النهضة” التي استُهدفت مقراتها قبل ساعات من قرارات الرئيس، ما دفع البعض إلى الربط بين الحدثين، انطلاقاً من سيناريو يقضي بإخراج الحركة الإسلامية من الحكم، وربما استئصالها نهائياً على غرار التجربة “السيساوية” (نسبة إلى عبد الفتاح السيسي).
صحيح أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة لـ”النهضة”، أصدرت بيانات ضد قرارات سعيّد، لا سيما تأويله للفصل 80 من الدستور، لكن الغنوشي وحده تحرك نحو البرلمان وجمع أنصاره للدعوة إلى “حماية الثورة والدستور”، ما يعني انقساماً مدنياً- إسلامياً، غير متبلور، بشكل مباشر خصوصاً أن النهضة بنت توافقات مع قوى متعددة، لكنه قابل للتبلور في أي لحظة، إذ إن القوى السياسية لديها استعداد للانخراط في أي معادلة جديدة على حساب النهضة، التي تشعر بأنها مستهدفة وتتحرك على هذا الأساس. أي أن القوى السياسية غير معنية بالدفاع عن ما بني من قواعد دستورية ضعيفة في البلاد بعد الثورة، بقدر ما هي معنية بإعادة إنتاج نفسها، بعد فقدان الشارع ثقته بها. “النهضة” لم تكن خارج، نقمة الشارع، لكنها تختلف عن بقية القوى بامتلاك بعد عقائدي– تعبوي يمكنها من التقدم في أي انتخابات، واستغلال ضعف الاخرين، وانفصالهم عن مصالح المجتمع، وهو ما حصل في الانتخابات الأخيرة حيث حصدت أكبر كتلة وبنت توافقات، سريعاً ما تأرجحت، وسط أوضاع سياسية شديدة التقلب.
إن استغلال ما يحدث للتصويب على “النهضة” بهدف تصفيتها، انطلاقاً من كونها إسلاماً سياسياً، وليست جزء من منظومة حكم غير منتج، ستكون له نتائج سلبية.
أزمة الثقة بين الأحزاب والناس، كانت نتيجة لضعف تأثير القواعد الدستورية لممارسة الحكم على أحوال المجتمع ومصالحه، فالتوافق الممل، أفرغ السياسة من كونها إدارة للشأن العام، وحول مؤسسات الحكم إلى لعبة مساومات وصراعات بين الأحزاب والقوى لا تبالي بأوضاع الناس ولا تنعكس على مصالحهم. ما يعني أن الفترة الانتقالية، التي كان من يفترض، أن تشهد تقوية المؤسسات، للانتقال إلى دولة تدير مصالح مواطنيها، أصبحت غاية بحد ذاته، وحلقة مفرغة، انتقال ينتج الانتقال، بدل أن يتطور، نحو ديموقراطية راسخة.
وانهيار الحزبية والسياسة، ضمن عملية انتقالية تأكل نفسها، كانت تتمته الطبيعية، عند شعبوي مثل قيس سعيّد، ربح انتخابات الرئاسة، نتيجة عاملين، خوف التونسيين من وصول منافسه قطب الإعلام المتهم بالفساد نبيل القروي للسلطة، واليأس من الطبقة السياسية المنشغلة بالتوافقات التي لا تترك أي أثر على حياة الناس. واليوم، لا يوجد أفضل من الظروف الحالية حيث الأحوال الاقتصادية المتردية، وخروج “كورونا” عن السيطرة، وتصاعد النقمة على السياسيين، ليعلن سعيّد قراراته.
من هنا، فإن، المعضلة في تونس حالياً، هي فشل في إدارة الفترة الانتقالية وقتلها بأولوية التوافق، وانفصال أحوال السياسة عن أحوال الناس، وظهور شعبوي سلطوي يقتنص الفرص للانقضاض على التجربة الدستورية الهشة أصلاً. بهذا المعنى “النهضة”، مسؤولة عن مشكلات البلد، ضمن مناخ سياسي واسع، وقائم على التوافق، غير أن الأخير، له مستوى آخر للفهم، غير ذاك المتعلق بالعلاقة التي أصابها الشلل بين السياسة والمجتمع في تونس. فهم يرتبط بتمايز الحركة عن أقرانها، من أحزاب الإسلام السياسي في المنطقة لا سيما مصر. فهي دخلت في تسويات سياسية، مع قوى مدنية، على عكس حزب “العدالة والحرية” في مصر الذي احتكر السلطة، بذريعة الشرعية، وحاول التوغل في مؤسسات الدولة، فضلاً عن أن علاقة النهضة بالعنف تكاد لا تذكر قياساً بحركات إسلامية أخرى في المنطقة، يضاف إلى ذلك وجود شخص مثل راشد الغنوشي، في قيادة الحركة، قام بمراجعات معمقة خلال وجوده في الغرب، وله مواقف متقدمة في قضايا كثيرة، غالباً ما تحرج أتباع الإسلام السياسي في العالم العربي، وتحرج أتباع الحركة أيضاً. أي أن الحركة تمارس التوافق، ضمن قواعد دستورية غير صلبة، ما يجعله إيجابياً لناحية قبولها بالآخر السياسي، وسلبياً لناحية الفاعلية وتحسين ظروف الناس.
وعليه، فإن استغلال ما يحدث، للتصويب على “النهضة” بهدف تصفيتها، انطلاقاً من كونها إسلاماً سياسياً، وليست جزء من منظومة حكم غير منتج، ستكون له نتائج سلبية، لناحية عدم الفرز بين تجارب الإسلام السياسي في المنطقة، وتقييمها انطلاقاً من قبولها بممارسة السياسة ضمن قواعد دستورية، ما يتيح معارضتها، وتغيير سلوكها. كما أن ذلك، لن يشكل حلاً لأزمات تونس، بل سيجعل الإسلاميين كبش فداء، لتأديب بقية القوى أو إعادة انتاجها في معادلة جديدة، تسلمه عبرها بنظام سلطوي على غرار مصر السيساوية.
لتجنب هذا السيناريو الأسود، يمكن التفكير بعيداً من شلل التوافقية، غير المنتجة، والتي تشترك فيها “النهضة”، ضمن مفارقة، ترتب سلبيات وإيجابيات، وكذلك بعيداً من حلول شعبوية يقترحها الرئيس قيس سعيد، لمنع سقوط التجربة الوحيدة، التي نجت من دول “الربيع العربي”.
درج
——————–
قيس سعيد ليس انقلابيا/ خيرالله خيرالله
ليس ما فعله الرئيس التونسي قيس سعيد سوى خطوة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تونس. الواضح أن الرئيس التونسي يمتلك دعما قويّا من المؤسسة الأمنيّة التي تصرّفت، أقلّه إلى الآن، بطريقة توحي بأنّها في تصرّف رئيس الجمهوريّة والقرارات التي اتخذها والتي تستهدف في الواقع حركة النهضة، التي ليست سوى فرع من تنظيم الإخوان المسلمين المتعطّش إلى السلطة.
الأهمّ من ذلك كلّه أن قيس سعيد رئيس منتخب من الشعب مباشرة. هذا يجعل منه رئيسا شرعيا يتصرّف بما تمليه عليه واجباته الوطنية التي تتجاوز مصلحة فئة معيّنة لا همّ لديها سوى الاستحواذ على السلطة.
أظهرت النهضة في السنوات الأخيرة، خصوصا منذ خروج زين العابدين بن علي من تونس أنّها القوّة الفعلية المنظّمة الوحيدة في البلد. كشفت تصرفاتها التي توّجت بوصول زعيمها راشد الغنوشي إلى موقع رئيس مجلس النوّاب أنّها تراهن على الوقت من أجل التمكّن من تونس. استخفّت دائما بأنّ الشعب التونسي مستعدّ للمقاومة وأن ليس من السهل إجبار المرأة التونسيّة على التخلي عن المزايا والمكتسبات التي تتمتع بها استنادا إلى قوانين عصريّة وحضاريّة لا علاقة لها بالإخوان المسلمين وتخلّفهم.
كذلك، أظهرت النهضة دهاء في تعاطيها مع الوضع التونسي وذلك منذ نجاح “ثورة الياسمين” واضطرار بن علي إلى مغادرة البلد. شيئا فشيئا تسللت إلى الإدارات التونسيّة. ساهمت في تضخيم جهاز الدولة وجعل المواطنين يعتمدون على رواتب من دون عمل منتج. ترافق ذلك مع تدهور مستمرّ للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ فوضى إداريّة جعلت الشركات الكبرى، بما في ذلك شركات التعدين تنسحب من تونس. كان واضحا رهان النهضة على نشر البؤس والتخلّف من أجل التمكّن نهائيا من تونس ومن صمود الشعب التونسي، وفي مقدّمه المرأة.
الأكيد أن قيس سعيد ليس الباجي قائد السبسي الذي يمتلك شرعية تاريخية والذي عرف كيفية التعاطي مع النهضة معتمدا على إرثه البورقيبي. لكن أحداث الأيّام الأخيرة كشفت طبيعة أخرى للرجل. تعتمد هذه الطبيعة على الجرأة والاستعداد للمواجهة. ليس قيس سعيد ضابطا نفّذ انقلابا لكنّه رئيس للجمهوريّة انتخب بأكثرية شعبيّة كبيرة، وقد وجد بلده يتفكّك أمامه. لم يكن لديه من خيار آخر غير المواجهة بدل الانكفاء ومشاهدة راشد الغنوشي يتفرّج على التجاذبات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أثبتت الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 عجزه عن تحمّل مسؤولياته في حدودها الدنيا.
ليس سرّا أن “ثورة الياسمين” التي افتتحت موسم “الربيع العربي” فقدت بريقها منذ زمن طويل. اعتبرت النهضة تونس بمثابة ثمرة ستنضج مع مرور الوقت ولا تنتظر سوى موعد القطاف مع ما يعنيه من انضمام تونس إلى البلدان البائسة في المنطقة العربيّة.
ليس قيس سعيد عازفا منفردا في مقاومته للنهضة التي تتحدّث حاليا عن “انقلاب” قام به رئيس الجمهوريّة. كان الانقلاب الحقيقي في امتناع قيس سعيد عن أخذ المبادرة والتفرج على بلده ينهار. كلّ ما في الأمر أن الرجل تحمّل مسؤولياته لا أكثر. الأهمّ من ذلك كلّه أن الشعب التونسي أثبت أنه يرفض الاستسلام للفوضى والتخلّف والمؤسسات الموازية لمؤسسات السلطة التي أنشأتها النهضة والتي تحوّلت إلى ثقوب سوداء في الدولة التونسيّة. هناك دولة تسير ببطء أحيانا وبسرعة كبيرة في أحيان أخرى نحو الاهتراء. هذا ما كشفته الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 التي أراد رئيس الحكومة من خلالها الاكتفاء بتقديم وزير الصحة كبش فداء.
ثمّة أسئلة كثيرة ستطرح نفسها في الأيّام المقبلة التي ستتظاهر فيها النهضة بأنّها متمسكة بالقانون والدستور. ليس معروفا عن أيّ قانون وأيّ دستور تتحدّث الحركة في بلد ترتكب فيه جرائم من نوع جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. أين التحقيق في الجريمتين؟ هل صارت تونس مجرّد بلد فالت لا مكان فيه لأيّ تطبيق للقانون أو للدستور… إلّا عندما يتعلّق الأمر بممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحياته؟
كان مفترضا في الذين تولوا السلطة بعد “ثورة الياسمين” التخلّص من عقد الماضي، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بإيجابيات عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. بنى بورقيبة مؤسسات راسخة لدولة حديثة وجعل تونس على تماس مع كلّ ما هو حضاري في هذا العالم. أحسن الثلاثي المؤلف من الضباط زين العابدين بن علي والحبيب عمّار وعبدالحميد الشيخ التخلّص منه في الوقت المناسب في العام 1987 بعدما تقدّم به العمر وبات أسير نساء القصر. في مقدمة النساء كانت ابنة أخته سعيدة ساسي. عرف بن علي كيفية التخلص من رفيقيه في الانقلاب على “المجاهد الأكبر”. تفرّد بالسلطة وتصرّف بضيق أفق سياسي. لكنّ ما لا يمكن تجاهله، على الرغم من الفساد الذي استشرى في ظل صعود نجم زوجته الثانية ليلى طرابلسي، أنّه أدار البلد بكفاءة عاليّة وساعد في نشوء طبقة متوسّطة تونسية وبناء اقتصاد يعتمد على الصناعات التحويلية وعلى الزراعة والسياحة وخدمات أخرى خلقت فرص عمل للتونسيين. فعل ذلك كلّه في ظلّ الاستقرار والأمن.
يُفترض في تونس تذكّر ماضيها من أجل تأمين مستقبلها. هل لدى قيس سعيد ما يكفي من المؤهلات التي تسمح له بطيّ صفحة التجاذبات التي عانت منها تونس في السنوات العشر الأخيرة؟ الأكيد أن تونس عند مفترق، لكن ما يشجّع على بعض التفاؤل أن قيس سعيد خرج من دور المتفرّج بعدما اقتنع بأن لا بد من الإقدام على خطوة في اتجاه إنقاذ تونس من براثن الإخوان المسلمين. ما يمكن أن يساعده في ذلك انضباط الجيش والمؤسسات الأمنيّة، أي الدولة العميقة في تونس، من جهة ووجود فئات شعبية واسعة وهيئات نقابية ومهنيّة مؤيدة له من جهة أخرى.
ليس قيس سعيد مدعوّا إلى إنقاذ “ثورة الياسمين” وحده. المسألة تهمّ الشعب التونسي كلّه الذي بات مستقبله على المحك. تكون تونس أو لا تكون تلك هي المسألة!
إعلامي لبناني
العرب
————————
تونس: سقوط قلعة «الإخوان» الأخيرة/ عبد الرحمن الراشد
يبدو أن الأبواب قد سدت في وجه جماعة «الإخوان المسلمين»، حتى عاصمتها البديلة، إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. بعد مصر والسودان، هاهي تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر حصونها المتهاوية.
ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، بل تـأخر سنوات عن موعده المتوقع. سقوطهم من جراء وجودهم شركاء في الحكم، وارتبطوا بالفوضى، والاغتيالات، وعمليات التعطيل المتعمدة لإفشال العمل الحكومي بعد أن أصبح خارج سيطرتهم.
ومع أن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، كان واضحاً في تحذيراته أن ما يحدث سيضطره للتدخل إلا أنهم اعتقدوا أنه لن يجرؤ، وسيستولون على الحكم من خلال تدمير قياداته. والتدابير الاستثنائية التي اتخذها جاءت عملية إنقاذ لما قبل الانهيار. فالبرلمان أصبح عاجزاً لهذا تم تعطيل اختصاصاته. كما أقال رئيس الحكومة بعد فشل حكومته. أيضاً قرر تحريك المتابعة القضائية في قضايا الفساد التي طالب بالتحقيق فيها مرات وتم تجاهل مطالباته السابقة. ألقى عدة خطابات يقول لهم إنه لن يسكت عن الفساد المنتشر، ويطالب بالتحقيق. وكانت الإجابة، أنها ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية. وعن عجز الجهاز الصحي في مواجهة انتشار جائحة «كورونا»، أيضاً، قيل له بأنها ليست من اختصاصاته.
أرادوا الرئيس صورياً، لكنه صار صوت المواطن التونسي، اليوم هو الرئيس الحقيقي، وأمامه فرصة لإصلاح ما فشلت فيه الحكومة والبرلمان.
المحير فهم دوافع الفوضى التي كانت مصطنعة. لماذا لم يتراجع قادة ونواب حزب «النهضة» في الأشهر الماضية لفك الاحتقان، الأرجح أنهم كانوا يعتقدون أن الأزمة ستدفع الناس للشارع، وتعيد سيناريو ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن خلال الفوضى يتسلقون سلم الحكم من جديد.
إشكالات حزب «النهضة»، أنها تريد الحكم من دون احترام قواعده التي جاءت من خلاله، وهي الآن تحتج على التدابير الطارئة بأنها مخالفة للدستور وأن قرارات الرئيس هي الانقلاب.
قيس بن سعيد، هو رئيس الجمهورية المنتخب، وفاز عام 2019 بفارق كبير. كيف لرئيس منتخب أن ينقلب على نفسه؟ الحقيقة ما يقوم به إنقاذ للنظام التونسي، ولتونس، البلد، من الفوضى التي كانت قد بدأت. الأزمات الصحية والمعيشية والدستورية هي التي دفعت للتغيير، وجزء كبير منها كانت وليدة المماطلات والتعطيل المتعمد. وفي كل مرة يريد الرئيس التدخل على اعتبار أن البلاد على شفا الكارثة يرد هؤلاء أن عليه أن يلزم قصره. مع استمرار الأزمات صار على الرئيس إما أن يستقيل ويلاحق مستقبلاً من قبل الخصوم بتهمة التقصير، أو أن يتدخل ويعلن عن التغيير الضروري.
البعد الآخر في معركة تونس، هو معركة منطقة الشرق الأوسط ضد هذه الجماعة التي تم اقتلاعها من السودان في عام 2019، ومصر في 2013. «الإخوان» في تونس أخذوا فرصة طويلة في الحكم، وكانوا النموذج الذي يؤكد أنهم جماعة دينية ذات مشروع سياسي فاشي لا محل له في هذا العصر.
الشرق الأوسط
————————–
في تونس فقيه الدستور وحاميه يعتدي عليه/ عبد الحميد عكيل العواك
تتعرض الدولة لخطر مفاجئ وجسيم يهدد كيانها أو سير مؤسساتها الدستورية، فتضطر الدولة إلى الخروج عن الشرعية العادية إلى شرعية استثنائية لمواجهة ظرف استثنائي.
اختلف الساسة في تونس، وتصادمت الأيديولوجيات، والخلاف طبيعة بشرية، وظاهرة مجتمعية، تحصل في كل مكان وزمان، وتختلف المجتمعات بآلية الخروج من الأزمات، فالشعوب الديمقراطية تلجأ إلى الوسائل السلمية التي نص عليها الدستور، والشعوب الأخرى التي تأخذ الدستور واجهة سرعان ما تنقلب عليه عند أول أزمة.
تعمد الرئيس التونسي إحداث مفاجأة بإعلان السلطات الاستثنائية التي نص عليها الفصل (80) من الدستور التونسي الحالي، فأحدث زوبعة سياسية داخل مؤسسات الدولة، وجدلاً دستورياً سياسياً، بين من يراه قد انقلب على الدستور ومن يأمل أنه استدعى الدستور لحل الأزمة.
الجذر التاريخي للفصل (80)
ولدت السلطات الاستثنائية المنصوص عنها بالفصل 80 أول مرة في دستور فرنسا لعام 1958 باقتراح من الجنرال ديغول، ليسدَّ نقص المنظومة الدستورية السابقة التي وقفت عاجزة عن حماية الدولة من الغزو النازي.
إذا كانت ولادة هذه المادة في فرنسا جاءت نتيجة تطور البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما مرت به هذه البنى من ظروف، وما تعرضت له من أزمات اضطرت الحاجة إلى ابتكار هذه المادة، فإن انتقال نص هذه المادة إلى الدساتير العربية كان نتيجة المحاكاة والتقليد للدساتير الغربية، وأخذ ما ينتجه الغرب سواء كنا بحاجة له أم لم نكن، وقد أخذها في البداية دستور الحبيب بورقيبة بالفصل 46 وأبقاها دستور 2014 بلا مبرر لبقائها.
تطبيق عملي للسلطات الاستثنائية
طبقت هذه المادة أربع مرات في ثلاثة بلدان، كانت المرة الأولى في فرنسا عندما استخدم الجنرال ديغول سلطاته الاستثنائية في 29 أيلول لعام 1961 للتصدي للحركة الانقلابية التي قام بها بعض قادة الجيش الفرنسي في الجزائر.
على حين شهدت مصر تطبيقها مرتين في ظل دستور عام 1971 في عهد السادات كان ذلك في 3 فبراير 1977 عقب أحداث يومي 18و 19 يناير من تلك السنة، حيث وقعت أحداث شغب واضطرابات قامت الحكومة بمواجهتها بإجراءات صارمة.
وعندما وقعت أحداث طائفية في بعض المدن المصرية في بداية صيف 1981، أعلن الرئيس في 5 سبتمبر سنة 1981 التجاءه إلى استعمال ما تخوله المادة (74) من الدستور لحماية الوحدة الوطنية من الفتنة الطائفية.
وأما المرة الرابعة فوقعت أمسِ عند إعلان تطبيقها في تونس.
ويجمع الفقه الدستوري على أن تطبيقاتها لم تكن متوافقة مع شروطها وغايتها، وكانت تشكل حالة اعتداء على الدستور.
الشروط اللازمة لتطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي
إن غموض نصوص هذا الفصل قد يفسح مجالاً واسعاً للجدل في تفسيره أو محاولة تحديد مضمونه.
لذلك فقد اتجه الفقه إلى ضرورة الالتزام بشروط استخدامه، وقسموه إلى شروط موضوعية، وشروط شكلية.
1-الشروط الموضوعية
نص الفصل (80) على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة” من هذا النص نستخلص الشروط الموضوعية:
أ- وجود خطر داهم
إنّ كلمة ((داهم)) التي وصف بها الخطر تنصرف إلى معنيين فهو مفاجئ وواقع، أو سيقع عما قريب، وليس خطراً زال أو انتهى.
وبالتالي لا ينطبق النص في حالة الخطر البسيط أو الوهمي أو التصوري أو الذي لم يبدأ أو الذي بدأ وانتهى، وكذلك في حالة الخطر المحتمل الوقوع بعد فترة، أو الخطر المستقبلي، لأنه يمكن الإعداد لمواجهته.
وبالتالي فإن الخطر الذي يبرر استخدام الفصل (80) لا بد أن يكون من قبيل المخاطر الاستثنائية التي تتجاوز المخاطر العادية وتجري في كل مجتمع، بحيث يتعذر مواجهتها باتباع الوسائل القانونية العادية، أو الوسائل الاستثنائية المقررة بالدستور.
ويلاحظ غياب الخطر بهذه المواصفات في الحالة التونسية، إذ إنه من قبيل الخلافات السياسية العادية ويمكن حله باللجوء إلى إجراءات الفصل 98 القاضي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.
ب- أن يقع الخطر مهدداً لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها
الخطر المهدد لكيان الوطن هو خطر مهدد لبقائها، سواء كان هذا الاعتداء ينصبّ على إقليمها الجغرافي بالتوسع العدواني على حساب أراضيها، أو خطر يتهدد مواطنيها من خلال زعزعة الوحدة الوطنية، أو الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تنتج عنها الأزمات الاقتصادية.
وهو ما لم يتوفر في حالة الإعلان الأخير، فلم يوجد خطر داخلي استثنائي وفجائي يهدد الدولة، وليس هناك عدوان خارجي يهدد استقلالها.
ت- أن يؤدي الخطر إلى تعذر السير العادي لدواليب الدولة
لقد اشترط الفصل (80) كأثر يجب توافره إلى جوار الخطر الجسيم والحال، بمعنى أنّه يجب أن يكون هذا الخطر مؤدياً بالضرورة إلى تعذر السير المنتظم للسلطات الدستورية العامة، فالشرطان يجب اجتماعهما معاً للجوء إلى الفصل (80).
وهذا لم يحدث في تونس على عكس من ذلك تعمد الرئيس التونسي تعطيل سير مؤسسات الدولة، فجمد عمل البرلمان وحل الحكومة.
2- الشروط الشكلية
أوجب الفصل (80) على رئيس الجمهورية اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية قبل أن يستخدم هذه السلطات، وهذه الشروط عبارة عن ضوابط إجرائية، تلزم رئيس الجمهورية بإجرائها حتى تكون الرؤية واضحة أمامه قبل استخدام هذه السلطة الاستثنائية الخطيرة.
أخذ استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
هذه الاستشارات لبعض المؤسسات الدستورية هي استشارات اختيارية غير ملزمة من حيث الأخذ بنتائجها، ولكنها ملزمة من حيث مبدأ إجرائها وطلبها، حيث تتوقف عليها المشروعية الشكلية لقرار الإعلان.
وقد أعلن الرئيس التونسي قيامه بهذه الإجراءات وهو ما نفاه رئيس مجلس نواب الشعب، وواقع الحال يؤكد صدق الثاني لأنه أعلن اعتراضه فور علمه بالإجراءات.
ب- توجيه بيان للشعب
ويعني هذا الإجراء أن يوضح الرئيس للشعب الظرف الاستثنائي الطارئ، وما يترتب عليه من خطر، وما اتخذه الرئيس من إجراء لمواجهته وهو بذلك يحيط الشعب علما بالإجراءات الاستثنائية، وانتقال البلاد من المشروعية العادية الواسعة إلى المشروعية الاستثنائية الضيقة.
3- محظورات على رئيس الجمهورية بموجب الفصل (80)
أ- اجتماع البرلمان وجوباً
لقد طلب الدستور من مجلس نواب الشعب أن يكون في حالة انعقاد دائم طيلة إعلان الظروف الاستثنائية، ومنع على رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب.
إن المشرع الدستوري قصد من الإبقاء على انعقاد البرلمان من أجل مباشرة مهامه الرقابية، إضافة إلى ما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مهام تشريعية، وبذلك يساعد المشرع العادي (البرلمان) المشرع الاستثنائي (رئيس الدولة) بالقيام بواجباته في مثل هذه الظروف الصعبة.
نرى بأن بقاء البرلمان في حالة الانعقاد هو ضرورة تفرضها الظروف الاستثنائية حتى لا يتحول الرئيس إلى دكتاتور دائم، بعدما حولته الظروف الاستثنائية إلى دكتاتور مؤقت، ولكن كان يجب توضيح دور البرلمان، وفض التداخل الذي سيحصل مع دور الرئيس الاستثنائي.
لقد عمد الرئيس التونسي إلى مخالفة صريحة لروح المادة فقد عطل أعمال المجلس الذي يجب انعقاده بشكل دائم، لقد عمل بتوجه معاكس للمشرع الدستوري وهو ما يرقى إلى مستوى الخطأ الجسيم في مخالفة الدستور.
ب- عدم جواز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة
ولرغبة المشرع الدستوري ألا تغيب الحكومة عن المشهد بهذا الظرف فقد عطل حق الرئيس بتقديم لائحة لوم ضدها.
ونرى بأنه لا يحق للحكومة أن تقدم استقالتها وفق الفصل (98)، كما لا يحق لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على “الثقة” في مواصلة الحكومة نشاطها، كل ذلك لأنه وجود الحكومة وما تملك من سلطات تنفيذية تكون البلاد أحوج إليها في الظرف الاستثنائي ومواجهة الخطر.
لقد تعمد الرئيس التونسي إلى حل الحكومة مخالفاً بذلك الفصل (80) الذي يمنع عليه تقديم لائحة لوم لأن البلاد بحاجة لجهد الحكومة.
لقد كان اعتداء رئيس الجمهورية واضح على الدستور ومخالفته الجسيمة لأحكام الدستور بينة، لذلك يجب على الشعب التونسي حماية دستوره من الاعتداء لأن الشعوب التي لا تحمي دساتيرها لا تنتظر من تلك الدساتير أن تحميها إذا ما اعتدى حكامها على شعوبها.
لقد كان ما فعله نكسة لمسيرة الديمقراطية التونسية، والديمقراطية تنتظر من الشعب أن يحرسها، من دون الالتفات إلى زاوية الخلافات السياسية الضيقة، لأن انحراف مسيرة الديمقراطية يعني الجميع في خطر، وواهم من يعتقد أنه ناج من هذا الخطر.
تلفزيون سوريا
————————–
تونس في مهب الوباءين: كورونا والصراع السياسي/ سميح صعب
أيهما أقسى على تونس؟ وباء كورونا أم وباء الصراع على السلطة الذي لم ينتهِ منذ إسقاط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011؟
ما كان يُعتبر قصة نجاح وحيدة في موجات “الربيع العربي” قبل عقد من الزمن، تحول بفعل نزاع لا هوادة فيه على السلطة، إلى عدم استقرار. والجولة الأخيرة منه كان إعلان الرئيس قيس سعيّد ليل الأحد-الإثنين تجميد كل أعمال مجلس النواب وتولي السلطة التنفيذية لـ”إنقاذ تونس”.
وأتت خطوة سعيّد بعد أشهر من الشلل السياسي بسبب الخلافات بين الرئيس من جهة ورئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم “حزب النهضة” الإسلامي الذي يساند رئيس الوزراء. والشلل السياسي ترك تونس فريسة لموجة قاسية من وباء كورونا، وسط غضب شعبي حيال الطبقة السياسية برمتها.
وكخطوة تعكس عمق الإنقسام السياسي داخل الحكم، كلف الرئيس سعيد الأسبوع الماضي الجيش، إدارة الأزمة الصحية في البلاد. وعلى رغم أن هذه الخطوة قد يكون لها إيجابيات على صعيد التصدي للفيروس، إلا أنها أثارت بعض المخاوف من تترك انعكاسات على الديموقراطية التونسية في المستقبل.
وأتت خطوة سعيّد غداة إقالة المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي المقرب من الرئيس ووصفه لقرارته بأنها شعبوية وإجرامية، بعدما دعا المهدي الشبان للتطعيم بشكل استثنائي.
ولم يترك سعيّد الأمر يمر من دون تعليق، إذ قال تعقيباً: “نحن لسنا في مجال للمنافسة، نحن دولة واحدة، ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة، القانون هو قانون الدولة، كثرت الأخطاء في المدة الأخيرة وكثر التردد نتيجة لدخول بعض اللوبيات، وأعي جيدا ما أقول، لإفساد جملة من الإجراءات”.
ولم تتمكن الطبقة السياسية التي حكمت بعد الثورة من تأليف حكومات مستقرة، وحال الإضطراب السياسي دون توفير الخدمات العامة للناس.
وانعكس الوباء على الوضع الإقتصادي في بلد ذي مديونية مرتفعة. وتتفجر احتجاجات بين الحين والآخر في أوساط الشباب بسبب الفقر والبطالة المرتفعة. وعلى رغم قيود كورونا، فإن احتجاجات حاشدة اندلعت الاحد وصبت غضبها على مقرات “حزب النهضة”.
وانكمش الإقتصاد 8.8 في المئة العام الماضي، وفق تقرير لصندوق النقد. وعلى رغم توقعات بنسبة نمو 3.8 في المئة هذه السنة، فإن النسبة لن تصل إلى ما كانت عليه قبل الوباء. وتلقت السياحة التونسية ضربة قوية في ظل قيود الإتحاد الأوروبي وبريطانيا على السفر. وتعتبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بـ4 مليارات دولار مسألة حاسمة لمساعدة الحكومة التونسية مالياً بينما يتجه الدين ليبلغ نسبة 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وزاد المأزق السياسي منذ انتخابات 2019، التي أفرزت برلماناً منقسماً بشدة بينما أوصلت سعيّد إلى الرئاسة.
وكان سعيّد عين المشيشي التكنوقراطي في آب (أغسطس) 2020، لكن العلاقة بينهما بدأت تتدهور تدريجيا وبلغ الخلاف ذروته بعد أن رفض سعيّد تعديلاً حكومياً أقصى وزراء محسوبين عليه. ولم يقبل رئيس الدولة أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين، مما أحبط التعديل وأدخل البلاد في أزمة دستورية. بناء على ذلك، كلف أعضاء في الحكومة الإشراف مؤقتاً على نحو عشر وزارات. ويحظى المشيشي بدعم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتزعم “حركة النهضة” الإسلامية.
ويرى مراقبون أن الحركة هي المسؤولة عن إضعاف المشيشي عبر إقحامه في نزاع مع الرئيس على رغم أنها تتنصل في العلن من مسؤوليتها عن إيصال الأمور إلى هذا الحد من التردي السياسي، الذي ينعكس على أداء كافة مؤسسات الدولة.
والخلافات الناشبة بين سعيّد والمشيشي والغنوشي فضلاً عن النزاعات المريرة بين الأحزاب المتنافسة في البرلمان والتي تحولت أحياناً إلى مشادات عنيفة، أضعفت من الثقة بالنظام السياسي القائم. ويرى البعض أن تونس قد تكون أمام أسوأ أزمة منذ الإستقلال عام 1956.
النهار العربي
—————————-
ثمن التخلص من «النهضة»… سؤال اليوم التالي في تونس/ حسام عيتاني
لا تكفي التظاهرات التي خرجت في شوارع تونس تأييداً لإجراءات الرئيس قيس سعيد للجزم بأن خطر «الإخوان المسلمين» قد رُفع نهائياً، وأن البلاد قد نجت من فوضى عارمة كانت ستقع فيها بسبب ممارسات حزب «النهضة». ويتسم بالقدر ذاته من التسرع القول إن الديمقراطية الوليدة في البلاد خضعت لحكم تسلطي يؤدي فيه العسكر الدور الرئيس في إدارة السلطة على النمط المشرقي.
تجمّعت غيوم أحداث الخامس والعشرين من يوليو (تموز) منذ انتخاب سعيد في 2019 وتشكيل الحكومة الأولى برئاسة إلياس الفخفاخ ثم استقالته بعد شهور قليلة، إثر ضغوط «النهضة». تولي هشام المشيشي المنصب قبل سنة، وإصراره على الطابع التكنوقراطي لحكومته كسبيل للنأي بها عن صراعات الأحزاب والرئاسة، لم يحل دون تعرضها لهجمات قاسية من كل الأطراف، وصلت إلى إقالة وزير الصحة فوزي مهدي بعد تحول وباء «كورونا» إلى كارثة وطنية وفشل الخطة الحكومية لتطويق تفشي المرض. الجديد كان دفع سعيد الجيش إلى تولي أدوار تنفيذية في حملة مكافحة الوباء في حدث عُد سابقة في تونس بإسناد مهمة كهذه إلى المؤسسة العسكرية.
أسهم الوباء من دون ريب في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد التونسي الذي انكمش في العام الماضي 8 في المائة، واضعاً مئات الآلاف من المواطنين في خانة البطالة والفقر. بيد أن المرض ذاته انقلب مادة للصراع السياسي، حيث تعرّض رئيس الجمهورية إلى اتهامات بالمسؤولية عن ارتفاع أعداد المرضى والوفيات بسبب حجبه المساعدات التي تصل إلى تونس عن الجهات الطبية.
بطبيعة الحال، ليس «كورونا» هو ساحة النزاع الوحيدة، ذلك أن لائحة الاتهامات لسعيد لا تبدأ مع اعترافه بعد تأييده الديمقراطية التي أنتجتها ثورة 2011 بعدم مشاركته في أي انتخابات جرت بعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولا تنتهي مع إحالته مدونين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، فيما اعتبرته منظمات حقوقية دولية انتكاسة في حرية التعبير عن الرأي، ووصولاً إلى معضلة تشكيل المحكمة الدستورية ودور البرلمان ومطالبته بتعديل الدستور ليتحول نظام الحكم إلى رئاسي تكون له فيه اليد العليا من دون أن يكون لديه أي مشروع واضح أو رؤية حقيقية لمستقبل تونس ونظامها السياسي.
القوة الرئيسية المعارضة، «حركة النهضة»، لم تكن أكثر وعياً والتزاماً بمصلحة البلاد. فبعد المرونة التي أبدتها في أزمة 2013 عندما كادت الأمور أن تفلت في الشارع بعد عمليات اغتيال سياسية اتُّهم إسلاميون بالوقوف وراءها واتهمت هي بالتستر على مرتكبيها، عادت «النهضة» إلى أسلوب المعارضة التي ترفض النظر في نهجها السابق، وذلك بقيادة راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة البرلمان ولا يحظى بكبير ودّ بين التونسيين بسبب ارتباط اسمه بالعديد من الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الثورة، وكذلك بسبب دوره في التغطية على سلوك الحركة التي انتقل آلاف من المحيطين بها والمقيمين على تخومها (وإن أنكرت أن يكونوا من أعضائها) للقتال في سوريا والعراق تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث شكّل التونسيون في إحدى مراحل الحرب السورية العدد الأكبر من عناصر «داعش».
كما أن الاغتيالات المذكورة وعدداً من العمليات الإرهابية في الأنحاء الشمالية والشرقية وفي العاصمة، كانت لها آثار ملموسة في تحفيز المعسكر العلماني المناهض الذي ألقى على «النهضة» لائمة التدهور الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
التجمع الذي دعا الغنوشي إليه أمام البرلمان الذي مُنع من دخوله لم يجذب الجماهير التي كان ينتظرها، على ما يبدو.
وإذا كان من الصعب حتى الآن الجزم بانحسار التأييد الشعبي لـ«النهضة» في قواعده التقليدية في الضواحي والأرياف التي مكنته في كل الانتخابات التشريعية السابقة من الحصول على كتل وازنة في البرلمان، فإن هذا الإخفاق قد يكون علامة على الاستياء العميق الذي تشعر به فئات واسعة من التونسيين حيال الحزب الإسلامي.
لكن السؤال يبقى: هل يعني ذلك أن إبعاد «النهضة» عن الحكم وعن مواقعها في البرلمان وفي الشارع يبرر اللجوء إلى كل الوسائل بما فيها تقييد العمل الديمقراطي الذي لاحت نُذره في قرار سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه والاستحواذ على سلطات المدعي العام وإقالة الحكومة؟
يبدو الخوف مشروعاً من أن التجربة الديمقراطية الوحيدة التي حققت نجاحاً نسبياً على الصعيد السياسي من بين دول الثورات العربية، قد تسقط في الاختبار الحالي وتسقط في هاوية تسلطية. لكن يُطرح هنا السؤال عن درجة التطلب الديمقراطي في البلاد العربية وهل يمتلك هذا النظام الحافل بالنواقص والثغرات التي يعترف بها أنصاره قبل خصومه، من المؤيدين في تونس من الذين يقبلون بما يتجاوز الإلغاء ويعتمد التعايش والحوار ولو كان مع مَن فشل في إبداء الحرص ذاته على الديمقراطية على غرار «النهضة»؟
الشرق الأوسط
————————-
خمسة سيناريوهات محتملة لتصاعد الأزمة التونسية
بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان، واندلاع مواجهات بين أنصاره ومعارضيه، طرح عدد من المحللين بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الأيام المقبلة في تونس.
أول هذه السيناريوهات حدوث عنف في الشوارع بين أنصار الرئيس وأنصار النهضة في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط، وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.
السيناريو الثاني قد يتمثل في تعيين الرئيس سعيد لرئيس وزراء جديد ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ(كوفيد – 19) والأزمة المالية الوشيكة، ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوماً، ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
أما السيناريو الثالث فهو حدوث سيطرة ديكتاتورية، حيث قد يحكم الرئيس قبضته على مفاصل السلطة في البلاد، وكذلك الأجهزة الأمنية، ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدستوري، ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع، وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.
وهناك أيضاً سيناريو رابع، يتمثل في وضع تعديلات دستورية وإجراء استفتاء وانتخابات، بحيث قد يستغل الرئيس سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه «تسوية دستورية مفضلة» لديه، وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناءً على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان. وقد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
أما السيناريو الخامس والأخير، فيتجلى في إمكانية حوار واتفاق سياسي جديد، بحيث يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة، إذ تقرر التراجع
———————-
=================
تحديث 28 تموز 2021
———————
تونس: طوفان الأسئلة/ محمد كريشان
لا بد من الاقرار أولا وقبل كل شيء بأن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية، أقال فيها الحكومة وجمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وجمع فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه، قد حظيت بترحيب شعبي واسع تجلى في مظاهرات الفرح في مدن عدة وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت يرد روّادها بعنف شديد على كل من يعتبر ما جرى انقلابا.
لم تعد هناك من فائدة الآن للتوقف عند قانونية وشرعية ما أقدم عليه الرئيس سعيّد فما جرى قد جرى وانتهى الأمر، وفي كل الأحوال لا وجود لمحكمة دستورية يمكن أن تبت في الأمر، لكن ذلك لا يحول أن يقف الجميع في تونس أمام طوفان من الأسئلة بدأ يتدفق رويدا رويدا في محاولة لفهم ما يمكن أن يحدث في مقبل الأيام، فالفرح أو الاستياء لحظات انفعالية سريعة لا تولّد حلولا.
طرفان أساسيان هما موضوعا هذه الأسئلة: من جهة وبالدرجة الأولى، الرئيس سعيّد. ومن الجهةالأخرى، حركة «النهضة» أكبر المتضررين مما جرى:
الرئيس سعيّد يقف الآن وحيدا ومباشرة في جبهة المسؤولية أمام شعبه وأمام العالم. لم تعد هناك حكومة يرمي عليها الفشل ولا برلمان يحمّله المسؤولية. هو حاليا وجها لوجه مع شعب قرف ممن كانوا يحكمونه ويتوسمون الخير فيه إذ يرونه الآن منقذا لهم من براثن عبثهم وفسادهم.
على الرجل أن يستعد الآن لسيل انتظارات الناس في حياتهم اليومية والبداية ستكون من طريقة التعامل مع جائحة كورونا وتهالك البنية الصحية وتعثر عمليات التطعيم، ثم في ما يواجهونه من غلاء معيشة وارتفاع مستمر في الأسعار ومضاربات في قوت الناس، وخاصة فقراء الحال الذين صوّر الرئيس نفسه نصيرا لهم، فكيف له أن يتعامل مثلا مع مالية عمومية منهكة أو حتى مفلسة؟.
سيترقب الجميع الآن كيف سيتصرف سعيّد مع من كان يتحدث دائما عن فسادهم بضمير الغائب.. هل يستطيع مواجهتهم الآن؟ وهل سيتعامل مع كل لوبيات الفساد على قدم المساواة أم سيسقط في ما سقط فيه من يلومهم من انتقائية ومحاباة فيضرب قسما ويتجاهل أو يحمي قسما آخر ممن يقال إنهم يتمتعون بغطاء أجنبي يحول دون أن يتجرأ أحد على الاقتراب منهم؟
كيف سيواصل الرئيس إدارة ملف التفاوض مع الهيئات المالية الدولية بعد أن أزاح الحكومة التي كانت مسؤولة عنه؟ وهل يمكن لهذه الهيئات أن تتفهم ما جرى في تونس أم سترى أنه من غير الوارد التورط في قروض لبلد غير مستقر ؟ كثير من التونسيين يرددون أنه لم تعد هناك من هيبة للدولة ولا للقانون وأن الارتجال والفوضى والمحسوبية هي التي باتت سائدة، فهل سيكون الرئيس قادرا على وقف ذلك؟ أو على الأقل الحد منه، وبأية أدوات؟
الرئيس سعيّد سيجد نفسه أيضا أمام انتظارات الطبقة السياسية والنخبة التي تأمل أن تكون اجراءاته ظرفية ومؤقتة وألا يعتبر التأييد الشعبي له صكا على بياض لعودة الاستبداد وحكم الفرد الواحد. لهذا سارعت كل الأحزاب والمنظمات الكبرى، وأبرزهم اتحاد العمال القوة الكبرى في البلاد، إلى الإعراب عن حرصها على الشرعية الدستورية والعودة إلى المسار الديمقراطي في أسرع وقت. كما أنه لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الردود الدولية الواسعة التي بدت حذرة تجاه ما يمكن أن يفعله في مقبل الأيام، خاصة وأن ما اتخذ ضد بعض وسائل الاعلام ومكاتبها ومراسليها بدا مقلقا حول مستقبل حرية الرأي والتعبير، المكسب الأبرز للتونسيين. الكل يتحدث الآن عن ضرورة الحوار لترتيب خارطة طريق للخروج من المأزق فهل سيتجاوب الرئيس مع ذلك وهو الذي كثيرا ما بدا ممانعا أو واضعا لشروط هذا الحوار؟
في المقابل، تجد حركة «النهضة» نفسها أمام سيل من التساؤلات هي الأخرى لا بد لها أن تواجهها بكل شجاعة وقدرة على النقد الذاتي والمراجعة. أول هذه الأسئلة وأهمها على الاطلاق هو لماذا كره أغلب التونسيين هذه الحركة إلى درجة التهليل لما فعله الرئيس رغم أنه قد يقود إلى المجهول؟ لماذا خرجت الناس فرحة مهللة للرئيس حتى في المدن التي كانت صوّتت من قبل بكثافة للحركة في الانتخابات؟ لماذا استبشر الناس بإزاحة هذه الحركة من المشهد حتى ولو بمجازفة قد تعيد البلاد القهقرى في مجال الحريات؟ لماذا اعتبرها الناس العاديون، وليس فقط المسيّسين المعادين لها أصلا، هَمّا وانزاح عن صدورهم؟ ما الذي فعلته الحركة وقيادتها حتى لا تجد أحدا من المتعاطفين معها إلا حزبييها؟؟ هل أن المزاج العام في تونس يرفض فعلا حكم الإسلاميين، أو حتى مشاركتهم فيه، أم إن هؤلاء لا يصلحون للحكم ولا يعرفون كيف يديرونه فتقلصت نسبة التأييد لهم مع كل انتخابات حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟هل آن لزعيم الحركة راشد الغنوشي أن يراجع الكثير من حساباته التي أوصلت الحركة إلى هذا المصير، رغم أصوات التغيير داخل حركته نفسها، أم سيعاند ويدفن رأسه في الرمال ويستعذب دور الضحية؟؟
ما زال سيل الأسئلة طويلا ولن ينجو أحد، ولا البلاد، إذا لم يُشرع من الآن في مواجهة لحظة الحقيقة هذه والبحث عن الأجوبة الشافية… وخاصة المقنعة.
كاتب وإعلامي تونسي
القدس العربي
————————-
تونس:في مخاطر إنتظار “ما يدور في ذهن الرئيس”/ عزمي بشارة
في الحلقة الثالثة من نقاشه للأزمة التونسية، التي نشرها على فايسبوك اليوم الاربعاء 28 تموز/يوليو، رأى المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، أن الاحزاب السياسية في تونس تتحمل مسؤولية تأجيج الشعبوية التي أتاحت للرئيس قيس سعيّد الانقلاب على الدستور، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تكتفي اليوم بالإنتظار او السؤال عما يدور في ذهن الرئيس( وهو سؤال مستوحى من أنظمة الحكم الدكتاتورية). وأكد بشارة على ضرورة أن تطالب القوى الديموقراطية التونسية رئيس الجمهورية، أن يفصح فوراً عما يريد ان يفعل، وأن تعلن تلك القوى على الفور أيضاً خطتها للمرحلة المقبلة.
وهنا نص الحلقة الثالثة:
(حلقة ثالثة)
في توقيت النقاش حول من يتحمل المسؤولية، وفي الشعبوية وما يدور في ذهن الرئيس:
1. سبق أن كتبت مرات عديدة محذراً من أثر ظواهر سلبية على صورة التعددية الديمقراطية لدى الجمهور التونسي، ومنها: تنقل نواب البرلمان بين الأحزاب (السياحة الحزبية وفق المصطلح التونسي) بحثا عن الفائدة الشخصية والمنصب، ونشوء أحزاب لا تمثل موقفاً أو فكراً أو قضية، لا لسبب إلا لسهولة الأمر، تبدّل الصفقات الحزبية وتغيّرها بموجب تكتيكات ومن دون استراتيجية معلنة، تراشق التهم غير المثبتة لغرض المس بالخصم، أي التشهير المتبادل، المبالغة في الحديث عن الفساد والمحسوبية وغيرها لتشوية الآخرين؛ ومع أنه يوجد في بعض الحالات أساسٌ واضحٌ لهذه الادعاءات إلا أن كثرة تردادها وإلصاق التهمة بالجميع تنفر الجمهور وتخلق انطباعاً أن جميع السياسيين فاسدون، وهذا غير صحيح؛ وأخيرا، الانطباع عن ديمقراطية بلا هيبة ولا تدافع عن نفسها بوجود حزب في البرلمان التونسي يعلن على رؤوس الأشهاد أنه مؤيد للنظام السابق، وأن هدفه تقويض الديمقراطية، ويقوم فعلا بالتهريج في البرلمان وتشويه صورة التعددية الديمقراطية (بتواطؤٍ واعٍ وغير واعٍ من الإعلام المهتم بالإثارة).
2. في ما عدا الظاهرة الأخيرة، هذه ظواهر قائمة في أي ديمقراطية. وفي جميع الديمقراطيات، شجع البث المباشر من البرلمان الشعبوية في خطابات النواب وفي رد الفعل في ثقافة الجمهور. وفي جميع الديمقراطيات ثعقد صفقات حزبية وائتلافات لاغراض الحكم والمعارضة. ولكن الديمقراطية حديثة العهد في تونس والجمهور ليس معتاداً على هذا النمط بعد، وكان على القوى المؤيدة للنظام الديمقراطي أن تبدي مسؤولية أكبر، كما أن الانتخابات غير المقيدة وأجواء الحرية فسحت المجال ليس فقط لمؤيدي الثورة ومعارضيها بخوض غمار السياسة والمزايدات، بل أيضا للمغامرين وغريبي الأطوار، وليس فقط للصحافة، بل لشبه الصحافة في التأثير في المشهد.
3. عقّد الدستور المختلط المشهد السياسي. كان المقصود أن يكون النظام برلمانياً، ولكن في النهاية أُدخلت فيه عناصر من النظام الرئاسي. المحكمة الدستورية لازمة في كل ديمقراطية، ولكن في حالة نظامٍ مختلطٍ معقدٍ كهذا يصبح وجودها ضرورة ماسة، وغيابها كارثة. ففي غياب محكمة كهذه تحمي الدستور وتفسر توازناته وحدود صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان قد تتحول العناصر الرئاسية في الدستور إلى حصان طروادة ضد النظام البرلماني. لم يحصل هذا بوجود رئيس مسؤول وعاقل مثل الباجي قايد السبسي (بغض النظر عن الخلاف مع مواقفه وسيرته)، ولكن، مع وصول شخص مناهض للديمقراطية إلى سدة الحكم، تحول الاحتمال إلى خطر حقيقي.
4. النظام الرئاسي في البلدان العربية هو مشروع استبداد (وفق اجتهاد البعض يلزم صلاحيات رئاسية أوسع في البلدان العربية المتعددة الإثنيات والطوائف حيث يمكن ان تمزق المحاصصة الطائفية وحدة النظام البرلماني). ولكن تونس دولة متجانسة إثنياً ودينياً، ولا أثر فيها للنزوع إلى المحاصصة الهوياتية. والنظام البرلماني هو الأصلح لها بعد عقود طويلة من حكم الفرد المستبد. ولكن الدستور أُقر، وهو دستور ديمقراطي يضاهي دساتير أعرق الديمقراطيات، ويجب ان تحميه محكمة دستورية.
5. يظهر خطر النظام الرئاسي في دول اعتادت مؤسساتها على تلقي أوامر الحاكم الفرد في سلوك أجهزة الدولة التونسية الطيع لأوامر رئيس يخرق الدستور، وذلك على الرغم من أن النخب الثقافية والسياسية لا تختلف معه فقط، بل تتحدث بجرأة متفاوتة عن سوية أعماله واقواله.
6. تتحمل الأحزاب الحاكمة في تونس مسؤولية بالطبع عما آلت إليه الأمور، وكذلك أيضا المزاودون الشعبويون الذين استغلوا عدم شعبية خطوات مسؤولة وضرورية. عند حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتخذ الحكومات في بعض الحالات خطوات غير شعبية، وتتضح في هذه الحالات قوة النظام الديمقراطي ورسوخه، وتشكل المزايدة الشعبوية في هذه الحالات أحد أهم العوائق أمام ترسيخه.
7. في تونس لم تحكم أحزاب الأغلبية البلاد في العامين الماضيين (لا يوجد حزب أغلبية بل أحزاب)، بل دعمت حكومة تكنوقراط من دون تمثيل حزبي فيها. وبدا البرلمان مكاناً للخصومة والثرثرة من دون فعلٍ حقيقيٍ، ما سهل العمل على تشويه صورته بتواطؤ (موضوعياً على الأقل) بين الرئيس المعادي علنا للدستور القائم وعناصر معادية للديمقراطية داخل البرلمان تحولت إلى مهرجٍ دائمٍ فيه. ولم تكسب حركة النهضة شيئا بل خسرت من تصدرها برلمان لا تمارس الأغلبية فيه الحكم. وبدا صراع الرئيس مع البرلمان (وهو في جوهره صراع مع البرلمان على الصلاحيات) وكأنه صراع مع حركة النهضة.
6. جميع الانقلابات في التاريخ، وأهم الإنتاجات النظرية اليمينية في تبرير الديكتاتورية الفاشية (وبعضها من إنتاح قانونيين مثل كارل شميت عشية صعود النازية) جاءت على خلفية التحريض على البرلمان (للمفارقة استخدم شميت تعبير المؤامرات في الغرف المظلمة في حديثه عن برلمان جمهورية فايمر) وتمجيد النظام الرئاسي الذي يمثل وحدة السيادة وعدم تجزئتها، وأهم تعبيراتها وفق شميت الحق في إعلان حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ عنده دائمة لأن البلاد دائما في خطر داهم. والنتيجة في ألمانيا معروفة.
7. حساب الذات ضروري، وكذلك تحمل المسؤولية، ينطبق هذا على الأحزاب التي أسهمت في تأجيج الشعبوية في الشارع. ويصح ذلك حتى على أحزاب فسدت وأخرى لم تفسَد ولكن أخطأت في اجتهاداتها وبالغت في تكتيكاتها. وعليها ان تستنتج النتائج. ولكن المهمة الحالية الملحة هي مواجهة مخطط الانقلاب على الدستور منذ كذبة محاولة الاغتيال وإلقاء الخطابات السياسية في الثكنات العسكرية فصاعداً… كيف يجوز لديمقراطي أن يستخف بهذه المهمة ويستغل الفرصة لتصفية الحسابات مع خصومه الحزبيين؟
8. تنتشر بين النخب التونسية حاليا عبارة ” لا أحد يعلم ماذا في ذهن الرئيس”، أو “ننتظر خطواته القادمة التي لا نعرف ما هي”. هذه مصطلحات نظام حكم ديكتاتوري يحكم من الغرف المظلمة (هنا يصح التعبير فعلاً). فقط في تلك الأنظمة يتعلق كل شيء بأمور مجهولة تدور في ذهن الرئيس.
9. لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية بترديد هذه العبارات، بل بعكس ذلك: أ- مطالبة الرئيس أن يفصح فوراً عما يريد أن يفعل وأن يكون هذا مطروحا للنقاش في البرلمان والصحافة وغيرها، فالنظام التونسي ليس رئاسياً، فضلا عن أن يكون دستوراً شكلياً لنظام ديكتاتوري، ب- يفترض أن يدور شيء ما في ذهن القوى الديمقراطية (المدنية والسياسية) غير انتظار ما سوف يفعله الرئيس، أقصد ان تخطط وتعلن خطتها للمرحلة المقبلة، وليس أن تنتظر ما سوف يفعل الرئيس.
10. ثمة في تونس مجتمعٌ مدنيٌ وسياسيٌ حي، ومؤسسات متمرسة مساندة للديمقراطية، وشعب يعاني من مشاكل وخيبات كثيرة، ومعرض بسبب ذلك للدعاية الشعبوية، لكنه شعبٌ ذاقَ طعم الحرية وحقوق المواطن، وقد تصبح هذه المزايا والكبرياء الذي يرافقها جزءاً من هويته الوطنية، وهذا أساس جيد لمخاطبته.
المدن
—————————
جدل في تونس: قرارات قيس سعيد… انقلاب أم إنقاذ؟/ فاطمة بدري
يذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أنشطة البرلمان وسلطاته وحل الحكومة وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، ونشر قوات الجيش حول عدد من المؤسسات الحكومية وإعفاء وزيري الدفاع والعدل، جدلاً وتبايناً في المواقف والآراء حول مدى شرعية تلك القرارات، وما إذا كانت انتهاكاً للدستور. فالمشهد بتطوراته الراهنة يُشكل منعطفاً يؤسس لمرحلة جديدة تبدو محفوفة بالمخاطر على أكثر من صعيد أمني وسياسي واقتصادي ودستوري.
الرئيس التونسي أعلن أنه يتحمل مسؤولية قراراته، مشدداً على أنها لا تشكل انقلاباً كما يروج البعض ولن تمس بالمكتسبات التي تحققت بعد ثورة يناير 2011، مؤكداً صون الحريات الخاصة والعامة وحرية التعبير.
وفي ظل هذه التطورات يستحضر تونسيون معظمهم من مؤيدي حركة “النهضة” الإسلامية أو من الأحزاب المتحالفة معها، “الانقلاب” عنواناً لتلك الإجراءات التي تعتبر بالمنطق السياسي من أكثر القرارات إثارة للجدل في مشهد سياسي مضطرب، وسط حالة احتقان اجتماعي ممتدة منذ تولي الائتلاف الحكومي الذي هيمن عليه الإسلاميون، السلطة.
في المقابل، يعتبر تونسيون تلك القرارات تصحيحاً للمسار وإنقاذاً للبلاد من حالة الانسداد والأزمات متعددة الرؤوس (سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية) بغض النظر عن شرعيتها الدستورية من عدمها، وهي في رأي كثيرين نتاج سنوات من الفوضى واستشراء الفساد وهيمنة لوبيات المنظومة التي تحكم البلاد منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 بقيادة حركة “النهضة” الإسلامية التي شكلت الضلع الرئيسي في ائتلافات ما يعرف بـ”الترويكا”.
ولا يمكن أيضاً النظر إلى تلك القرارات بمعزل عن حالة الشدّ والجذب بين رأسي السلطة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية تعديل وزاري أجراه المشيشي وتضمن أسماء حولها شبهات فساد وتضارب مصالح، ما دفع الرئيس قيس سعيد للاعتراض عليها ورفض أن يؤدي الوزراء محل الشبهات اليمين الدستورية أمامه، ليفضي هذا الوضع إلى قطيعة سياسية بين الرئيس ورئيس الحكومة المدعوم من حزام سياسي شكلته حركة “النهضة” وحلفاؤها.
ويذهب البعض إلى توصيف قرارات سعيد بأنها أشبه بـ”انقلاب” كان لا بد منه بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إصرار الحكومة وحزامها السياسي على العناد والمكابرة والمضي في سياسات أغرقت البلاد في أسوأ أزمة.
فبينما كان الوباء يفتك بالتونسيين مع عجز الدولة عن كبح تفشي العدوى، كانت حركة “النهضة” الشريك الرئيسي في الائتلاف الحكومي، تعد لإقرار تعويضات بمئات ملايين الدولارات لمنتسبيها وقياداتها التي تقول إنهم تضرروا من حكم النظام السابق، بينما تئن البلاد تحت وطأة أسوأ أزمة مالية. حصل ذلك بينما يغرق التونسيون في الفقر والبطالة بالموازاة مع تردي القدرة الشرائية وموجة غلاء غير مسبوقة.
وعلى رغم أن قرارات الرئيس التونسي حظيت بترحيب في أوساط شعبية عكسته الاحتفالات الليلية، إلا أنها أثارت في المقابل مخاوف على مكاسب الثورة التونسية ومنها التعددية الديموقراطية والحريات العامة وحرية التعبير. قيس سعيد طمأن بأنه لا مساس بتلك المكاسب وأن ما حصل لم يكن انقلاباً، مؤكداً أن الأمر يتعلق بإنقاذ تونس من “العصابات واللصوص”.
وزاد من تلك المخاوف قيام قوات الأمن التونسية باقتحام مكتب قناة “الجزيرة” القطرية وإغلاقه، وهي خطوة وصفها مدير المكتب لطفي حجي بأنها “سابقة” لم تحدث مع أي وسيلة إعلامية أخرى، معتبراً ما حدث “خطوة كبيرة للوراء”.
وفيما وصفت حركة “النهضة” وحلفاؤها ما حدث بانقلاب على الشرعية وعلى الدستور، أعلن حزب “حركة الشعب” (يسار) مساندته قرار الرئيس التونسي بتجميد سلطة البرلمان لمدة شهر.
الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في تونس وصاحب تأثير سياسي واجتماعي قوي، شدد في بيان أصدره بعد اجتماع طارئ على ضرورة أن يُرفق الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية التي أعلنها وفق مقتضيات الفصل 80 من الدستور، بجملة من الضمانات الدستورية وعلى رأسها “ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً من التّوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم”.
وذكّر أيضاً بأنه سبق أن نبه في أكثر من مرة من الأزمة التي تردّت فيها البلاد، مضيفاً أنها (الأزمة) “قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام”.
وأشار إلى أنه نبّه “لاستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طوراً وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء تارة لمصلحة لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة دينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار”.
وشدد المكتب التنفيذي الوطني لـ”الاتّحاد العام التونسي للشغل” في ختام اجتماعه الطارئ على “رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف”.
محمد عبو الوزير الأسبق والأمين العام السابق لـ”حزب التيار الديمقراطي” الذي كان أحد أضلع الترويكا الأولى والثانية التي قادتها حركة “النهضة” بعد ثورة يناير 2011، اعتبر أن ما قام به الرئيس قيس سعيد ليس انقلاباً، مضيفاً أن لا المؤسسة الأمنية ولا العسكرية قامت بانقلاب.
وتابع أن ما يقوم به سعيد هو معركة ضد الفساد، مضيفاً أن قيادات في حركة النهضة متورطة في الفساد حتى النخاع، متهماً الحركة الإسلامية بتكوين عصابة داخل الدولة.
أكثر من جهة سياسية أيدت قرارات الرئيس التونسي، لكنها لم تخف في المقابل مخاوفها من عودة الدكتاتورية وسلطة الفرد الواحد.
“حزب العمال اليساري” رأى أن “تصحيح مسار الثورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق”، في أول تعليق له على قرارات الرئيس قيس سعيد.
وقال في بيان، “من الناحية القانونية هو خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديموقراطية تجسّد مسعى سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد”.
واعتبر أن قرارات سعيد تؤسس لمرحلة جديدة، من شأنها أن تفاقم خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة، بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب.
وحزب العمال عضو في ائتلاف أحزاب يسارية كانت اتهمت “النهضة” بالتورط في اغتيال كل من السياسي اليساري والحقوقي شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي قبل سنوات في أول اغتيالات سياسية ضربت تونس.
وعلى رغم معارضته لقرارات الرئيس التونسي، دعا حزب العمال إلى إسقاط منظومة الحكم برمتها: رئاسة وبرلماناً وحكومة، مشدداً على ضرورة محاسبة رؤوس هذه المنظومة وفي مقدمتها حركة “النهضة”.
واتهم المنظومة السياسية بأنها “تسببت في خراب اقتصادي وإفلاس مالي وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد في التبعية والمديونية وتدمير أركان حياة التونسيات والتونسيين”.
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عبر عن رفضه قرارات سعيد، معتبراً أنها “انقلاب”، مضيفاً في رسالة نشرها في “فايسبوك”، “ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور. سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات”.
وقال إن الرئيس التونسي اعتبر نفسه رئيسا للجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول”، محذرا من أنه في حال “نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي (للبلاد) أكثر”. كما اعتبر أن سعيد أصبح أكبر مشكلة لتونس وأن ما حدث يعتبر “قفزة جبارة إلى الوراء”.
والمرزوقي حليف سابق لـ”النهضة”، لكنها تخلت عنه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والذي اضطر بدوره للتحالف مع الإسلاميين بمنطق أن “تونس لا تحكم إلا بالتوافقات”.
ولاحت إثر القرارات بوادر صدام بين أنصار قيس سعيد وأنصار النهضة أمام البرلمان لكن الاحتكاكات كانت محدودة في معظمها بينما تبقى احتمالات التصعيد واردة.
وقد يسرّع سعيد في تعيين رئيس وزراء جديد للتعامل مع الأزمة الوبائية والانهيار الاقتصادي، ولاحتواء التوتر على جبهة الخصوم، من دون أن يعود عن القرارات التي أعلنها. وقد يلجأ إلى تسويات سياسية تحقق الأهداف المعلنة من قراراته بما فيها ضبط الانهيار وهذا الأمر يتطلب توافقات وترتيبات مع قوى سياسية ومع الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب النفوذ الاجتماعي والسياسي القوي.
الناشط السياسي عدنان منصر اعتبر أن الانتقال الديمقراطي كان وصل إلى مداه قبل حركة قيس سعيد، وتحول في نظر عدد كبير من التونسيين، وبالممارسة والتجربة، إلى احتيال ديموقراطي. قيس سعيد جسد لدى هؤلاء الشخصية التي ستجهز عليه.
وقال لـ”درج”، “هناك سؤال يطرح: هل كان تغيير الأمور ممكناً دون حركة، كالتي فعلها قيس سعيد؟ بالفعل لقد تم إغلاق أي آفاق لتغيير عميق في الوضع، سواء بالدستور أو بالقوانين أو الممارسة القمعية. الرغبة في ترسيخ الهيمنة بالتحكم الكامل في الفضاء السياسي أدى إلى احتقان جعل الثمرة تنضج، ثم جاء قيس وقطفها”.
وأضاف، “موضوع الحريات موضوع مهم جداً. على قيس سعيد ألا يستهين بهذا الموضوع. هذا الموضوع هو الذي دفع الناس للخروج مرات كثيرة منذ 2011، وآخرها يوم 25 تموز/ يوليو من مصلحة قيس ألا ينسى ذلك، وأن يفهم أن ما يراه من ابتهاج هو رصيد سريع التآكل”.
درجة
—————————–
قيس سعيّد يستوحي من عبد الفتّاح السيسي/ جلبير الأشقر
كل من يدّعي أن التدابير «الاستثنائية» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأحد الماضي هي إجراءات «دستورية» إنما يحاول عبثاً تغليف تأييده لما هو انقلاب سافر على الدستور وعلى الشرعية الديمقراطية بغلاف شفّاف للغاية. والحقيقة أن ادّعاء سعيّد نفسه بأن قراراته «دستورية» إنما يشير إلى أن فهمه للقانون الدستوري مستمدّ من تجربته في منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995، وفي منصب نائب رئيس تلك الجمعية منذ عام 1995، في ظل دكتاتورية زين العابدين بن علي التي يعلم الجميع مدى اعتمادها على الحذافير الدستورية.
فإن المادة 80 من الدستور التونسي التي استشهد بها سعيّد تنصّ على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب». كما تنصّ المادة عينها على أنه «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
فحتى لو افترضنا أن وضع تونس كان قد بلغ «حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها» وهو افتراض بعيد عن الواقع، فإن قيس سعيّد قد خرق الدستور بكل وضوح بإقالته لمجلس الوزراء وتجميده لمجلس نواب الشعب ورفعه الحصانة عن أعضائه بالجملة، عوضاً عن استشارة رئيسي المجلسين. كما أنه لمن الجلي تماماً أن قرار سعيّد «تجميد» مجلس النواب لا يعدو كونه احتيالاً منافقاً على النصّ الدستوري الذي حرّم حلّ المجلس في ظلّ العمل بالمادة 80 بغية الحفاظ على الديمقراطية من خلال موازنة السلطة التشريعية للسلطات التي قد يمسك رئيس الجمهورية بزمامها بحجة الحالة الاستثنائية. بل إن سعيّد قد حصر كافة السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية (النيابة العامة) بين يديه ضربة واحدة بما يتعدّى الصلاحيات التي منحها لنفسه كلٌّ من زين العابدين بن علي في انقلاب «7 نوفمبر» (1987) وعبد الفتّاح السيسي في انقلاب «3 يوليو» (2013).
أما ما خوّل ذلك فليس حيازة سعيّد على شرعية شعبية خارقة، وقد انتخُب رئيساً بأصوات أقل من 40 بالمئة من مجموع الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل عامين (72.7 بالمئة من أصل 55 بالمئة أدلوا بأصواتهم) بعد أن صوّت له أقل من 9 بالمئة من الناخبين في الدورة الأولى (18.4 بالمئة من أصل 49 بالمئة أدلوا بأصواتهم). بل إن ما خوّل سعيّد تنفيذ انقلابه ليس سوى تأييد القوات المسلّحة التونسية لقراراته، والحال أن صورة الاجتماع الذي ضمّه وقادة الأجهزة المسلّحة التونسية عند إعلانه لقرارته كفيلة بأن تؤكد لمن ساوره شكّ في الأمر أن ما جرى في تونس يوم الأحد الماضي هو انقضاض على الديمقراطية من نوع ما ألفنا في منطقتنا كلمّا تأزّمت الأوضاع في بلد ما.
وقد أكّدت الأحداث صحة التقدير الذي تم التعبير عنه على هذه الصفحات بين دورتي الانتخابات التونسية قبل عامين في مقال بعنوان «أهم دروس الانتخابات التونسية» («القدس العربي» 17/9/2019) أشرنا فيه إلى «علّة أساسية في النظام الدستوري الذي اعتمدته كلٌ من مصر وتونس بعد ثورتيهما والذي يستوحي من الأنظمة الرئاسية، الفرنسي منها على الأخص، فهذه صيغة قليلة الوفاء لشروط الديمقراطية الفعلية. وقد كان أحرى بالبلدين أن يعتمدا نظاماً برلمانياً مصحوباً بآليات ديمقراطية حقيقية تتيح للناخبين استبدال نوّابهم لو حاد أي من هؤلاء عن الأهداف التي تمّ انتخابهم من أجلها. وهذه الصيغة الأخيرة هي الوحيدة التي تليق بشعبين قاما بثورتين كان عنوانهما العريض «الشعب يريد»… فإن شرعية الرئيس أياً كان، الذي سوف تتمخّض عنه الدورة الثانية المقبلة في تونس، قد وُلدت هزيلة للغاية بما سوف يجعل حكمه حكماً بالغ الهشاشة في مرحلة من تاريخ تونس سوف تشهد لا مُحال عواصف اجتماعية متعاظمة. وبدل أن يستطيع الشعب فرض مشيئته على الحكم بآليات ديمقراطية، سوف تؤدّي الأوضاع إلى أزمات سياسية ودستورية، لاسيما أن الغموض يكتنف الصلاحيات الرئاسية في النظام الدستوري التونسي الراهن. وهذا دربٌ محفوف بالمخاطر قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى الوأد بالديمقراطية على غرار ما حصل في مصر».
وعلى غرار ما حصل في مصر قبل ثماني سنوات، فإن الجسم الأعظم لليسار التونسي متمثلاً بالحركة العمّالية، التي تعبّر عنها قيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل» قد وقع في فخّ تأييد الانقلاب والتوهّم (وإيهام الشعب في آن واحد) بأنه مجرّد «تصحيح» للمسار الديمقراطي، مثلما فعلت أبرز قوى اليسار المصري إزاء انقلاب «3 يوليو» علماً بأن منظمات سياسية يسارية تونسية مثل «حزب العمّال» الذي يرأسه حمّة الهمّامي قد أدانت تدابير سعيّد وحذّرت من انزلاق البلاد من جديد نحو الدكتاتورية.
كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
————————–
قيس سعيّد .. ملاحظات شخصية/ أرنست خوري
الكتابة عن شخصية قيس سعيّد مسألة حسّاسة، ذلك أن أخلاقيات الصواب السياسي تفرض عليك حصر الخلاف بالممارسة والخطاب والسلوك: ارفع الموضوعي وأسقط الذاتي، تقول النصيحة المهنية. الشخصي ــ النفسي يصبح، بهذه المعايير، عيباً يدنو من مرتبة قلة الأخلاق، وهذه طريقة تفكير قاصرة عن إدراك كثير من الجوانب السياسية عند من يشتغلون فيها. الرجل ارتضى بأن يكون شخصيةً عامة. إذاً، لمَ التردّد في تناول شخصيته؟ يقول لك كتاب الصواب إيّاه إنّ عليك الاكتفاء بالمضمون لا بالشكل. لكن مهلاً، منذ متى كان سلوك السياسي منفصلاً عن شخصيته؟ هل يمكن للشكل أن ينفصل عن المضمون؟ تريد أن تبتعد عن صحافة التابلويد الصفراء وعوالم النميمة والتطفل عبر تحييد شخص قيس سعيّد عن أدائه، فتجده كأنه يعيدك إلى ألف باء السياسة وعلم النفس: لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين، كذلك لا صدق من دون صادقين. أما وقد ارتكب فعلته الانقلابية مع آخرين ستكشف هوياتهم الأيام المقبلة، فإن كل ما كنت تفكّر فيه عن الرجل قبل الخامس والعشرين من يوليو/ تموز، شهر الانقلابات، يأتي إليك في صندوق واحد، كل قطعة شخصية فيه تحيلك إلى جزئية من فسيسفساء الانقلاب الذي لا بوادر كافية بعد لمواجهته شعبياً وسياسياً. لغته الفصحى المهجّاة التي تشعر أنها مفتعلة، عجرفته، صنميّته، نبرته الزجرية المستقاة من مدارس التلقين والحفظ من دون تفكير، فوقيته التي لا يجهد لإخفائها، استعاراته غير الأدبية بالمرة، كيف يحكي وكأنه يستظهر ما سبق له أن حفظه عن ظهر قلب قبل نصف ساعة، فظاظة مصطلحاته التي تثير سخرية أحياناً بدل أن تبثّ الرعب عند الخصوم. كيف يسمح بوضع نفسه فوق البشر وفوق السياسيين عندما يهاجمهم، وكأنه لاعب كرة مثلاً لا علاقة له بالشأن العام. هذا شيء مما يحضر إلى الذاكرة في مقاربة الذاتي بالموضوعي في انقلاب قيس سعيّد.
منذ بلوغه موقعه صاعداً من اللاشيء سياسياً، وهو الذي يتباهى بأنه لم يشارك في أي استحقاق انتخابي منذ الثورة، كان قيس سعيّد شخصية استفزازية. محافظ حتى الثمالة يشنّ حروباً مفتوحةً على المحافظين. يقول إنه ابن الشعب وصوته فتبحث في معاجم الذاكرة لعلك تجد شخصيةً في مخيلتك بعيدةً بقدر ما أنه هو بعيد عن الناس. كاره للسياسة يدّعي أنه مفكّر سياسي ومنظّر “اللجان الشعبية” في القرن الـ21. محارب أزلي لدستور عام 2014 لكنه متخصّص في تفسيره لتبرير انقلابه، بعدما أدّى قسطه في عرقلة تأليف محكمة تكون وظيفتها الحصرية شرحه والفصل في الخلافات حول غموض بنودٍ فيه، متى وُجدت. لا يتعب من تكرار العبارات البليدة نفسها عن عظمة الثورة، فيضرب أهم ما أنجزته، أي الديمقراطية، بلكمةٍ يُخشى أن تكون قاضية، إلى حين. الديمقراطية لا تنزل عن شفتيه، لكنه في الوقت نفسه، يكره الأحزاب والدستور والانتخابات والنظام السياسي والفصل بين السلطات، لكي تستحيل الديمقراطية في تعريفه، تسلّطاً باسم مستعار. يعيّن نفسه رئيساً للنيابة العمومية، ثم يؤكّد حرصه على استقلال القضاء. ولكي تكتمل قصة إهانة عقول المستمعين، يجاهر بأنه لم يجد أفضل من كارثة إنسانية اسمها كورونا لكي ينفذ انقلابه، فجعل “مئات الموتى بكورونا يومياً” في مرتبة “الخطر الداهم” الذي مد له الجسر ليعتلي المادة 80 من الدستور، وفق فهمه وحده لها. أكذوبة محاولة الاغتيال التي ادّعى الرجل وجودها لتصفيته تلخّص الكثير من ذوبان الذاتي والموضوعي والنفسي في كيانه السياسي.
ما ذُكر أعلاه، وكثير غيره، كوّن في مخيال خصومه صورة الرئيس الشعبوي غير الجاد. صورة جعلتهم يستخفّون بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه نرجسيته. فاتهم إبقاء العين على البطة السوداء ذات البذّة المرقّطة. بالغوا في إبداء حسن النية حيال العسكر وها هم يجدون أنفسهم من دون خطة عمل.
قيس سعيّد، تكاد تجعلنا نكره لغتنا العربية الجميلة يا رجل. هذه وحدها تستحق أن تُحاسَب عليها، قبل الانقلاب وبعده.
العربي الجديد
————————–
ردّ بايدن على تطورات تونس: محاكاة لتعامل أوباما مع انقلاب مصر 2013/ فكتور شلهوب
ردّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على التطورات التونسية المتسارعة، يذكِّر بتعامل إدارة باراك أوباما مع التغييرات السياسية التي شهدتها مصر عام 2013. فهو يحاكي إلى حدّ بعيد الموقف الذي اتخذته واشنطن آنذاك، ولو مع الاختلاف بين الحالتين في الأدوار والمواقع وأسلوب التغيير. في المرتين كان التعاطي هو نفسه تقريباً، حيث بقي في حدود الوعظ وإسداء النصائح، وبدا كأنه أقرب إلى شراء الوقت ريثما يستقر الوضع الجديد. وفي المرّتين لم تدخل الإدارة على خط الأزمة، إلا بالاضطرار، بعد أن علت الضجة وبات الوضع يهدّد بالأخطر. وفي كليهما، خلا الموقف من التحذيرات الجدية، فضلاً عن الإدانات أو التلويح بردود مكلفة لو تمادت الخطوات باتجاه عملية انقلابية.
في اليومين الأخيرين، صدرت عن الإدارة تصريحات وبيانات، وأجريت اتصالات تكررت فيها ذات العبارات: “نحث”، “نراقب الوضع من كثب”، “نشجع على الحوار”، ندعو إلى “التزام المبادئ الديمقراطية”… وما شابه من هذه البضاعة. نائبة المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية، جالينا بورتر، لم تخرج اليوم في مؤتمرها الصحافي عن هذا الإطار. تقيّدت به حرفياً. وعندما سُئلت عمّا إذا كانت الإدارة تنوي مطالبة الرئيس التونسي الآن أو في وقت لاحق، بالتراجع عن قراره بتعليق البرلمان وعن إقالة رئيس الحكومة، قالت: “لن أذهب إلى أبعد مما جاء في بيان الوزارة” عن المكالمة التي أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الاثنين، مع الرئيس التونسي قيس سعيد. فيها اكتفى الوزير بـ”تشجيع الرئيس على التمسك بالمبادئ الديمقراطية والعودة إلى الحوار مع القوى السياسية كما مع الشعب التونسي”. وبقية التصريحات اندرجت ضمن هذا الخط. المتحدث نيد برايس قال إن الإدارة “تقف مع الديمقراطية”، من غير أن يفصح عن الجانب الذي يمثلها. الناطقة في البيت الأبيض جين ساكي، أعربت عن “القلق” من دون أن تحدّد مصدره. وأكثر ما حمل على الاستغراب، كان إعلان البيت الأبيض أنه ينتظر فتوى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان الذي حصل في تونس يرقى إلى “مستوى الانقلاب”. وكأن هناك انقلاباً قانونياً وآخر غير قانوني.
مثل هذا التعليل ترك تساؤلات عما إذا كان في الأمر محاولة لتمييع ما يحصل في تونس، ما أثار انتقادات في الكونغرس، مع التحذير من عواقب تمرير مثل هذا الخروج عن أصول اللعبة، وحثّ الإدارة على التجرؤ وإدانة الإجراءات التي قامت بها السلطات التونسية. لكن الإدارة لا تبدو حتى الآن أنها في وارد انتهاج سياسة من هذا النوع. وفي الاعتقاد، أن الرئيس بايدن يحاذر الانخراط في أزمة شرق أوسطية جديدة “تنتهي به إلى ورطة”، في وقت يحاول فيه لملمة بقايا ورطات الحروب الأخيرة في المنطقة.
لكن الابتعاد عن ورطة يخشى الغرق فيها لا يعفيه من مأزق، لو تفاقمت الأزمة التونسية. فهو لم يترك مناسبة تحدث فيها عن السياسة الخارجية، إلا شدد خلالها على نقطتين أساسيتين: عودة أميركا إلى دورها القيادي في العالم، وأهمية دعم الديمقراطية في الصراع مع التوجهات والأنظمة السلطوية، مع التشديد على أن “الديمقراطية وحدها قادرة على الإنجاز”. الأزمة التونسية تتحدى هذا الطرح. ترمي الكرة في ملعب بايدن لجهة اتخاذ موقف مبدئي منها على الأقل، خصوصاً أن إدارته مهتمة بإنجاح المحاولة الديمقراطية، ولو الهجينة، لدى الجار الليبي. بخلافه، سيكون الرئيس بايدن في تونس أمام ما شارك فيه نائب الرئيس بايدن في أثناء انقلاب مصر في 2013، إذا ما سارت الأمور نحو الانقلاب الذي يتزايد الحديث عنه.
العربي الجديد
———————————-
تونس في مأساتها وملهاتها/ شادي لويس
البطل في التراجيديا مصاب بالعمى، يتقدم بثبات نحو حتفه، بثبات وشجاعة أيضاً. العمى لديه ليس مكمن الهشاشة، بل هو جوهر بطوليته، يصارع متخطياً الأهوال ومتغلباً عليها، حتى يصل إلى هلاكه الأكيد. وتفرض الحبكة دائماً سقطة واحدة ومريعة، كخطيئة أولى تتبعها سلسلة من الأحداث، لقدرٍ هادرٍ يصوب وجهه نحو حافة الكارثة. المأساة ليست فخاً، بل مساراً مرسوماً. لكن البطل لا يرى ما ينتظره تحت قدميه، شخوص المسرحية من حوله يعرفون، هم في معظمهم أو جميعهم، جزء من المؤامرة أو الخيانة أو متعاطفون معه، لكن في موقع العجز. مبكراً ينكشف للجمهور كل شيء، هول المأساة في هذا تحديداً، لا في المفاجأة ولا في ضربات المصير العشوائية، بل في قسوة توقعها، كونها مكشوفة ومتبجحة ولا يمكن منعها مع هذا، في أنها معروفة بتفاصيلها للجميع، ماعدا البطل.
لماذا يقع “إخوان” تونس في أخطاء “إخوان” مصر نفسها؟ ولماذا يسلك خصوم هؤلاء الطريق ذاته الذي سلكه غيرهم؟ لماذا لا يرى الأصدقاء في تونس ما نراه… نحن الجمهور، الجالسين بعيداً وفي الصفوف الأخيرة، لماذا لا يصدقوننا؟
أبطال الأساطير ليسوا بالحمقى، لكن شائبة واحدة تكون نقطة ضعفهم المفضية إلى الدمار، حسن النية أو الطيش أو غريزة الانتقام، وفي أحيان كثيرة الخيلاء. فهم، على الأغلب، من أنصاف الآلهة وأنصاف البشر. تخلق المجتمعات أساطيرها، حتى المعاصر منها يصنع بعضها ويؤمن بها بإخلاص، أساطير مؤسَّسة على بعض الحقيقة وبعض الأحداث العارضة، بعد أن تُضفى عليها صبغة المطلق.
تونس هي الاستثناء. الجيش التونسي لم ولن يكون أبداً جزءاً من اللعبة السياسية، وكأن الماضي ضمان للمستقبل، الشعب واعٍ، ولا يمكن أن يرضى أبداً بعودة الاستبداد مع مَن لا يعرف من هو الشعب: الذي صوت “للنهضة” في الانتخابات؟ أم الذي يحتفل في الشوارع اليوم؟ تلك المناعة المتخيلة والإيمان بجواهر ثابتة للأشياء، ربما هي ما يحجب الرؤية.
“إن التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة”، عبارة ماركس الشهيرة تتكلم عن المسرح اليوناني بقدر ما تتكلم عن التاريخ. العلاقة بين التراجيديا والملهاة ليست علاقة بين التكرار الأول والثاني، بل بين نوعين متمايزين من التكرار. أحدهما تنبع مأسويته من قابلية توقعه، كونه معروفاً سلفاً بشكل مؤلم، كما في التراجيديا. أما الآخر، فعلى النقيض، تكمن هزليته، في إنه غير قابل للتصديق، في أنه تشابه مستحيل، في أن مصر ليست تونس، وأن تونس ليست مصر، كما أن المرء لا ينزل إلى النهر مرتين، وأن قيس سعيد ليس جنرالاً عسكرياً مثل السيسي، ومع هذا يبدو كل شيء مكرراً. البطل الكوميدي ليس أحمق أيضاً، الهزل لا يكمن في الفشل مع كل محاولة جديدة للتكرار، بل في الإصرار على المحاولة، بشكل آلي، وبهذا العناد شبه البطولي والهزلي في الوقت نفسه.
لكن، من حسن الحظ أن التاريخ ليس مسرحاً، فالعالم خليط من الإثنين: أي المأساة والملهاة معاً، ومن تكرار هذا وذاك. وحين يتعلق الأمر بالثورة، فإن ماركس نفسه يحض على نوع من ضرورة التكرار أو التكرار الضرورة، ذلك التكرار الذي يبدو مع هذا مستحيلاً، أو معجزة.
تضع التطورات الأخيرة، تونس، على حافة المجهول، التعليق المؤقت للبرلمان لا يأتي مقروناً بخطة طريق واضحة ولا حتى تقريبية لما سيحدث خلال الأيام الثلاثين المقبلة، ولا ما عليه أن يحدث بعدها. الحماسة الواسعة في الأوساط العلمانية لقرارات الرئيس، تبدو مقلقة، أكثر من تركيز السلطات في يده. التصعيد من قبل حزب “النهضة” ومؤيديه وارد، وعواقبه فادحة. أما انطلاق حملة قمعية ضده بغرض استئصاله، فأمر وراد بالقدر عينه، وعواقبه لا تقل كارثية على الجميع. يمكن التعويل بالطبع على وساطة “اتحاد الشغل” والأحزاب الأخرى، وربما أطراف خارجية، وعلى ضغوط الشارع وحسن النوايا، من أجل الوصول إلى تسوية من نوع ما. تعويل يوحي لنا بأن التكرار، كما أنه نوع اليأس، هو أيضاً وجه للأمل.
المدن
————————–
لنرفع الصوت دفاعاً عن الثورة التونسية
الاحتفال بقرارات سعيد غير الدستورية علامة خطيرة جداً، وقرار الغنوشي المواجهة في الشارع ينطوي أيضاً على احتمالات واقعة رابعة في القاهرة.الثورة التونسية هي كل ما تبقى لنا من الربيع العربي المهزوم. فلنرفع الصوت دفاعاً عنها، لأن في ذلك دفاع عن أنفسنا.
ما تشهده تونس خطير جداً، فبلاد الياسمين هي ما تبقى لنا من رحيق الربيع العربي، وها هي تترنح بين طموحات رجل من الزمن البورقيبي، بمره هذه المرة، وليس بحلوه، وبين جشع الإخوان المسلمين إلى السلطة. إنه السيناريو المصري نفسه، والخوف كل الخوف أن تحصل تونس على النتيجة نفسها. انقسام حاد في الشارع مثله اليوم تظاهرتان أمام مجلس الشعب، واحدة تحتفل بقرارات الرئيس قيس سعيد التي انطوت على حرفٍ واضح للدستور، وثانية في مواجهتها يحاول فيها جمهور حركة النهضة حماية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من غضب مناوئيه، فيما الجيش الذي يفصل بينهما لن يبقى مكتوف اليدين لفترة طويلة.
السؤال الأبرز اليوم هو عن موقع الجيش من هذه المواجهة.
صحيح أن الجيش كان قرر خلال ثورة العام 2010 أن يقف على الحياد وأن لا يحمي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما اقتصرت المواجهة على قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وهذا ما جنب تونس الكثير من الدماء في حينها، وأمن انتصار الثورة، إلا أن ذلك يجب أن لا يدفعنا إلى الإطمئنان، فالجيش في مصر أيضاً تخلى عن حسني مبارك، إلا أنه عاد وانقض على الثورة ونتائجها، وهو وجد في ظل فشل الإخوان في السلطة قاعدة اجتماعية وسياسية لانقلابه، فتمت الإطاحة بإنجازات الثورة في سياق الإطاحة بالإخوان.
كل هذه العناصر متوافرة بالمشهد التونسي اليوم.
فشل هائل للحكومة وللطبقة السياسية في التعامل مع الكارثتين الاقتصادية والصحية، وتقف على رأس هذا الفشل حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس الشعب، والرجل الذي يملك نفوذاً كبيراً في الحكومة. وفي مقابل هذه السلطة، رئيس جمهورية قليل الصلاحيات آت من خلفية أكاديمية وجديد العهد بالعمل السياسي، ولا يخلو من طموحات شعبوية تعود بأصولها إلى فهم “بورقيبي” للسلطة بوصفها النقاء المترافق مع القسوة والشدة، وضعف في الحساسية حيال الحريات العامة.
يحضر الجيش أمام هذه المعادلة لكثيرين بوصفه مخرجاً من هذا الاختناق. لكن الجيش إذا ما أتيحت فرصة الحكم سيأتي بجنرال إلى قصر قرطاج، وبجنرالات إلى مقر الحكومة في القصبة، خصوصاً أن من تولى حل الحكومة وتعطيل البرلمان لا يملك تمثيلاً سياسياً يرشحه لالتقاط المشهد وإعادة تصويب الواقع السياسي. الواضح أنه استعان بالجيش، وهذا الأخير وحده من يتولى اليوم إدارة النزاع. ومن المرجح في حال لم يتراجع قيس سعيد عن قراراته، أن لا تبقى المؤسسة العسكرية في موقع إدارة النزاع، وستتقدم خطوة نحو الاستيلاء على الحكم.
ليس مبكراً الخوف على تونس. فشل حركة النهضة كبير، والاحتقان في الشارع بلغ ذروته، وأفقد الناس خوفهم من تعاظم جائحة كورونا، وفي المقابل التقط رئيس الجمهورية الفرصة وذهب في المواجهة خطوة أبعد مما يخوله الدستور فعله!
السيناريو المصري يجب أن يكون درساً. الاحتفال بقرارات سعيد غير الدستورية علامة خطيرة جداً، وقرار الغنوشي المواجهة في الشارع ينطوي أيضاً على احتمالات واقعة رابعة في القاهرة.
الثورة التونسية هي كل ما تبقى لنا من الربيع العربي المهزوم. فلنرفع الصوت دفاعاً عنها، لأن في ذلك دفاع عن أنفسنا.
درج
———————–
انقلاب الديكتاتور الحالم/ ديفيد هيرست
لكم وددت وتمنيت لو كنت مخطئاً تلك المرة، وأنَّ الوثيقة التي نشرناها في مايو/أيار وتُفصِّل كيف سيسيطر قيس سعيد على تونس ويقوض الدستور ويغلق البرلمان، كانت مُختلَقة. في ذلك الوقت، تعرضت لانتقادات بسبب تلك الوثيقة. وقيل لي إنه لا يوجد مثل هذا المخطط، وإنها نتاج صلاتي بالإسلاميين. لكن الحقيقة أنَّ مصدر الوثيقة كان علمانياً من داخل مؤسسة الرئاسة نفسها.
على مدى السنوات العشر الماضية، تدحرجت تونس من أزمة سياسية إلى أخرى، لكنها تمكَّنت بطريقة ما من النجاة لتكون آخر الصامدين بين دول الربيع العربي. ولم تكن الوثيقة مجرد رسالة عابرة وقعت من صندوق البريد الرئاسي، مثلما أكد قيس سعيد نفسه بعد أربعة أيام بعدما أُجبِر على الاعتراف بأنَّ الوثيقة حقيقية. بل كانت خطة واضحة المعالم وضعها مستشاروه الأقرب.
وجاء في الوثيقة، التي كشف عنها موقع Middle East Eye، أنه بعد استدراج رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إلى القصر واحتجازهما هناك، سيُعيَّن اللواء خالد اليحياوي وزيراً للداخلية بالإنابة.
وهذا ما حدث صباح الإثنين، 26 يوليو/تموز. إذ كُلِّف اليحياوي بالمنصب ليكون الرجل الذي يقود الحملة التي تُنفَّذ الآن ضد السياسيين والصحفيين.
ولم يقتصر الأمر على استيلاء سعيد على جميع السلطات التنفيذية، بل عيّن نفسه أيضاً مدعياً عاماً. وتُصوَّر أفعال سعيد من مؤيديه على أنها رد فعل على الدمار الذي أحدثه الوباء بالبنى الاقتصادية والسياسية بالبلاد. لكن في وقت تسريب الوثيقة، لم يكُن الفيروس قد عاث فساداً في تونس كما هو الحال الآن.
انقلاب الأحد، 25 يوليو/تموز، لا علاقة له بالفيروس، بل خُطِط له في وقت كان الفيروس تحت السيطرة.
سامية عبو، إحدى أنصار سعيد، من التيار الديمقراطي، التي رحبت بخطوات سعيد، كشفت هذه الحقيقة بقولها يوم الأحد، 25 يوليو/تموز، إنَّ “القرارات الرئاسية دستورية وتاريخية. وكان على الرئيس أن يتخذها منذ فترة”.
ببساطة.. انقلاب محض
ووصفت الوثيقة، المُصنَّفة بأنها “في غاية السرية”، هذه الخطة بأنها انقلاب دستوري. لكن ما حدث ليل الأحد تجاوز حدود الدستور بكثير. ينص الدستور على أنه عند تفعيل المادة التي تسمح للرئيس بممارسة سلطات الطوارئ، يُجبَر البرلمان على الانعقاد المستمر، ولا يمكن حله. لكن في الواقع، علَّق سعيد عمل البرلمان وعزل أعضاءه.
ويعتمد تفعيل المادة الـ80 على المحكمة الدستورية، التي منع سعيد البرلمان من تشكيلها، برغم أنه بموجب الدستور ينتخب البرلمان أربعة فقط من 12 عضواً بها.
عياد بن عاشور هو أبرز أستاذ دستوري تونسي، وكان شخصية جوهرية في صياغة الوثيقة الانتقالية والدستور وقانون الانتخابات، كما كان رئيس الهيئة التي أدارت الفترة الانتقالية في 2011. وهو علماني ولا يدعم الإسلاميين، يرى أنَّ ما حدث انقلاب “بمعنى الكلمة”.
بدوره، قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنَّ اللجنة في “حالة صدمة”.
جميع المؤسسات التي أُنشِئَت بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكل ما أفرزته ثورة 2011 لوضع تونس على طريق الديمقراطية، بغض النظر عن ميولها السياسية، تقاوم تصرفات سعيد.
لا يوجد شيء دستوري في هذا الانقلاب. هذا ببساطة انقلاب محض مثل الانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي في مصر عام 2013 وحاول الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا عام 2016. وتعارضه تقريباً كل الأحزاب في تونس؛ من جناح اليسار إلى اليمين، ومن العلمانيين إلى الإسلاميين: النهضة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، والجمهورية، وليس بأقل منها التيار الديمقراطي نفسه الذي تنتمي إليه سامية عبو.
وليس من الصعب معرفة السبب؛ ففي العالم العربي، بمجرد أن تستولي على كل السلطة، لا تعيدها. ولم يُخفِ سعيد رغبته في تغيير النظام السياسي في تونس. فقد كان المشيشي، رئيس الوزراء الذي اصطدم معه، من تعيين سعيد، وصدَّق عليه البرلمان. لكن اتسعت الخلافات بين الرجلين عندما رفض سعيد المصادقة على التعيينات الوزارية للمشيشي.
لم يكن الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء أيديولوجياً؛ إذ لم يكن أي من الوزراء سياسياً، ولم يكن لحركة النهضة أي يد في اختيارهم. كان من المفترض أنها حكومة تكنوقراط. وكان الخلاف حول السلطة، وسعيد يريدها كلها.
من حالمٍ إلى ديكتاتور
في النهاية، كان أستاذ قانون مستقل مثل سعيد، وليس اليد الحذرة من النظام القديم مثل الباجي قايد السبسي، هو الذي سَطَر تجربة تونس مع الديمقراطية. ويُحسَب للسبسي أنه قاوم الأموال المعروضة من أبوظبي لقمع حزب النهضة. بدلاً من السجون والدماء اختار فن التسوية السياسية. ونتيجة لذلك، انهار حزبه لكن تونس لم تنهَر. ومثل هذا الفن هو لعنة بالنسبة لسعيد، الدخيل الذي لا يوجد خلفه حزب سياسي، والذي كان يدعمه حزب النهضة باعتباره البديل الأقل سوءاً بين مرشحي الرئاسة.
وصف نضال مكي- الذي درس تحت يده- قيس سعيد بأنه حالم يسعى إلى التغيير الجذري عندما يتولى الرئاسة. وقال نضال لموقع Middle East Eye في عام 2019: “سعيد لديه بعض التحفظات بشأن طريقة ممارسة الديمقراطية التمثيلية وتجربتها في تونس. هو لا يعارضها معارضة قاطعة، لكنه يود تصحيحها من خلال إدخال جرعة من الديمقراطية المباشرة”.
بيد أنَّ سعيد أثبت أنه مصدر عدم الاستقرار السياسي؛ إذ اتسم حكمه بالتأرجح بين التهديد والتهدئة. وفي أبريل/نيسان، ادعى أنه كان القائد الأعلى لكل من الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد، عندما وضع الدستور القوى الداخلية تحت سيطرة رئيس الوزراء.
وفي يونيو/حزيران، أعاد كتابة التاريخ التونسي بمفرده بالقول إنَّ فرنسا ليس لديها ما تعتذر عنه من حكمها الاستعماري لبلاده. وأعلن سعيد أنَّ تونس كانت تحت “الحماية” الفرنسية وليس الحكم الاستعماري. وبالنظر إلى عدد التونسيين الذين اُغتيلوا واغتُصبوا في ظل الحكم الاستعماري منذ عام 1881، فإنَّ هذا الإعلان يتطلب بعض الغطرسة.
لكن انحرافات نظامه الكثيرة لها اتجاه سياسي واحد. وكان دافعه الوحيد لإحباط تشكيل المحكمة الدستورية مراراً وتكراراً- على الرغم من اختيار أربعة من قبل الرئاسة، وأربعة من البرلمان وأربعة من القضاء- هو إلغاء وجود الهيئة التي يمكن أن تحكم بأنَّ تحركاته غير دستورية.
وبصفته أستاذ قانون، يمكن للمرء الاعتقاد أنَّ مبدأ الفصل بين السلطات متأصل في شخص مثله. لكن سعيد لا يعترف بأخطائه ولا يتحمل مسؤولية معاناة التونسيين. الفوضى التي تدب في الحكومة هي من صُنعِه، وهو ما ستعرفه تونس قريباً بعدما حيّد سعيد البرلمان وحجب المعارضة السياسية.
في لحظة، تعلن الرئاسة أنها تلقت 1000 جرعة من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ من الإمارات، وتنتشر شائعات بأنَّ عدداً من البرلمانيين والمسؤولين حصلوا على التطعيم بالفعل. ثم في اللحظة التالية، تنفي الرئاسة علمها بوجود مثل هذه “الهدية”.
آخر الناجين
على مدى عشر سنوات، انتقلت تونس من أزمة سياسية إلى أخرى، لكنها تمكَّنت بطريقة ما من الصمود لتكون آخر الناجين بين دول الربيع العربي.
لم يكن حزب النهضة مثل الإخوان المسلمين في مصر؛ فقد تراجع وتخلى عن السلطة طواعيةً، وأبرم صفقات لتقسيم المعارضة. لكنه لم يستطِع تحقيق التغيير الاقتصادي الذي كانت بلاده في أمسِّ الحاجة إليه. وبالنسبة للتونسي العادي، وخاصة الشباب، تدهورت الأوضاع من سيئ إلى أسوأ.
وخلال أغلب تلك الفترة، لم يكن حزب النهضة يسيطر على البلاد أو الحكومة، لكنه كان يناضل من أجل إنشاء مؤسسات مثل البرلمان، والمحكمة الدستورية التي من شأنها ترسيخ تونس دولةً ديمقراطية.
إذا كانت التجربة التونسية مع الديمقراطية قد وصلت بالفعل إلى نهايتها؛ فهذا يعني أنَّ التونسيين سيقبلون حُجّة الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم العربي بأنهم ليسوا مستعدين للديمقراطية، وأنهم لا يصلحون إلا للديكتاتوريين الهشّين والأشرار.
لا أعتقد أنَّ الربيع العربي قد مات، ولا أعتقد أنَّ الشعب التونسي مستعد للعودة إلى حكم الرجل الواحد. ويمكن أن تثبت الأيام التالية أنني على حق مرة أخرى.
هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.
عربي بوست
——————————
الانقلاب الدستوري التونسي والسيناريو الأسدي/ رفقة شقور
اتخذ الرئيس التونسي قيس السعيد ليلة ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢١ مجموعة من القرارات تحت بند الوضع الاستثنائي، وتمخضت تلك القرارات عن تعطيل العمل بالأحكام الدستورية، فيما جوهره الانقلاب على العملية الدستورية، فقام بتجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وترأس قيس السعيد النيابة العامة للتحقيق في القضايا التي اتهم بها أعضاء البرلمان وبذلك يكون القاضي الأول والخصم والحكم، تولى أيضاً قيس السعيد السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه هو شخصياً، واتبع ذلك بإقالة رئيس الوزراء الحالي وتعيين بديل له من اختيار رئيس الجمهورية، ويكون رئيس الوزراء مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية، ويتم تعيين أعضاء الحكومة الذين يقترحهم رئيس الوزراء بقرار من رئيس الجمهورية.
تتابعت ردود الفعل على الانقلاب الدستوري الذي قام به قيس السعيد، وسط ترحيب كبير ممن دعموا انقلاب السيسي العسكري في مصر، كذلك وسط تهليل واسع من أنصار بشار الأسد، وكل من يعاني عقدة الإخوانوفوبيا في المحيط العربي، حيث رحبت شخصيات سياسية يسارية بالانقلاب وصورته على أنه صراع بين إسلامويين والرئيس فيما هو صراع بين الرئيس والشرعية الدستورية ومكتسبات الثورة التونسية من الديمقراطية.
تشابه ما قام به قيس السعيد إلى حد كبير مع انقلاب حافظ الأسد حين كان وزيرا للدفاع وعضوا للقيادة القطرية لحزب البعث على رفاقه وقادته الحزبيين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 فيما عرف بالحركة التصحيحية في سبيل تأسيسه لمملكة الصمت الطائفية عام 1971 حين انتخب رئيسا للجمهورية السورية بأغلبية شعبية، واستمد أسباب استمراره من خارجها وما زال حتى الآن الأمر ذاته بعد أن استمد الديكتاتور الابن شرعيته من احتلالات الأرض التي أتى بها إلى سوريا.
ما حصل من ترحيب بعملية الانقلاب الدستوري هو مؤشر على ميل تلك الأطراف التي رحبت لتصفية حساباتها الأيديولوجية، وخلافاتها السياسية مع الإسلاميين بدرجة أولى بعيداً عن المبادئ الديمقراطية واحترام قيم الدستور والشرعية، وهذا بحد ذاته اختبار آخر أمام تلك الأطراف المؤيدة والتي ينتمي جزء كبير منها لتيار اليسار العربي في مدى تغليب تلك الأطراف للقيم والمبادئ الديمقراطية وانتصارها لحقوق الإنسان على إهانتها لتلك المبادئ بالترحيب بخطوات انقلابية انتقامية أجراها الرئيس التونسي الذي لم يلبث أن جلس على مقعد الحكم حتى أظهر نهماً وجشعاً بالحكم شبيه بما أظهره سابقوه.
يتمثل الاختبار الحقيقي للتيارات اليسارية والعلمانية العربية هو أمام مثل هذه الأحداث التاريخية، وانحياز اليسار العربي لخيارات الحكام المستبدين كما حصل في سوريا والآن في تونس ما هو إلا مؤشر على الأزمة المبدأية والأخلاقية الحادة التي تعانيها تلك التيارات واصطفافاتها الغير مبررة تحت خيمة القرارات الشعبوية والخطابات الشعبوية التي لا تحترم مكونات الشعوب العربية كافة بما فيها الإسلاميون الذين لطالما كانوا مكونا أساسيا من مكونات المشهد السياسي في الدول العربية.
فيما تشكل ضريبة الصمت التي قد يتكبدها الشعب التونسي في حال لم يتحرك لإبطال هذا الانقلاب الدستوري نفس الضريبة التي دفعها الشعب السوري لعقود جراء انقلاب حافظ الأسد الذي ترافق حينها بترحيب ودعم شعبي، في حين أدركت قلة مدى خطورة ما قام به حافظ الأسد، حيث كان من الممكن في حينها توسيع الغضب الشعبي في البدايات إلا أن الصمت الشعبي تتابع لعقود حتى قامت الثورة السورية أخيرا، واليوم الشعب التونسي أمام خيار توحد كل شرائحه الحزبية في مواجهة الانقلاب على الشرعية، أو الصمت الذي سيتبعه اجترار التجربة السورية لعقود.
إن لم تدرك مختلف الأطياف الحزبية في تونس في لحظتها هذه أن مهمتها الدفاع عن الديمقراطية وتمسكها بمكتسبات الثورة، وأن ما يحصل بالبلاد ليس مواجهة حزبية بين طرفين من برامج مختلفة، فإنه سيسهل على رئيس الجمهورية المنقلب على الشرعية فرض البرنامج الواحد ورؤية الرجل الواحد على مختلف تيارات الحياة السياسية في تونس، وقد بدأ ذلك بالفعل منذ أن بدأ رئيس الجمهورية بتعطيل عمل البرلمان والحكومة ورفض إنشاء محكمة دستورية تفصل في الخلاف بين السلطات والتوازن بينها، كذلك تجاوزه المتكرر للفصل بين السلطات الثلاث.
أما بالنسبة للجيش التونسي فقد ظل لعقود على الحياد فيما يتعلق بالنزاعات السياسية الداخلية، كما أنه وقف إلى جانب الشعب التونسي في ثورته ضد بن علي، إلا أن ما أقدم عليه قيس السعيد من خطوات واسعة ومنع الجيش التونسي للبرلمانيين من الدخول للبرلمان مؤشر على أن قيس السعيد استمال قيادة الجيش التونسي لصالحه فيما يشكل تغيراً في أدوار الجيش التونسي التي حافظ عليها لعقود متتالية.
ما يحصل الآن من التفافة واسعة على العملية الديمقراطية هي من أكثر السيناريوهات شيوعاً في ظل عمليات التحول الديمقراطي في الدول حديثة التجربة مع الديمقراطية، وعكس ما يصوره المرحبون بالانقلاب الدستوري بأن البدائل والخيارات منحصرة بين ديمقراطية برلمانية أو رئاسية، وإنما البدائل التي يفرضها المشهد منحصرة بين الديمقراطية والرجوع لديكتاتورية حكم الرجل الواحد.
إن درجة المقبولية التي سيبديها الشعب التونسي وأجهزة أمن الدولة والجيش هي التي ستحدد مدى نجاح قيس السعيد في انقلابه على الشرعية، بينما في حال كان التصدي الشعبي والحزبي واسع لهذه الخطوات فإن الجيش التونسي سيعود لصف الشارع وينتظم بالدور التاريخي الذي لم يخرج عنه لعقود في ظل النزاعات السياسية الداخلية.
كما الفرصة الآن إلى جانب الشعب التونسي في حال اتخذ خياراً بالتمسك بالخيار الديمقراطي، والتصدي للعبث الرئاسي بالدستور ومكتسبات الثورة، كذلك الفرصة في صف الأحزاب اليسارية العربية في عكسها للأساس الحقوقي الذي تأسست عليه، والذي لطالما خرجت عنه في العقد الأخير حين تغاضت عن مقتل ٩٠٠ مسجون سياسي مصري في السجون المصرية حين دعمت السيسي في مقابل الخيار الديمقراطي الذي أفرز الإسلاميين، كذلك فرصة لها لاستعادة صوتها الذي ساندت فيه براميل بشار الأسد التي انهالت على أبناء شعبه، المطلوب من الأحزاب التونسية أيضا أن تنقذ أدوارها السياسية كاملة بعيداً عن الابتزازات السياسية والتصفيات الحزبية حتى لا تجد نفسها خارج المشهد السياسي وقد أصبح رئيس الجمهورية رئيس البرلمان والقاضي الأول.
كل ما سبق مقترن بوعي الشارع التونسي، والمؤسسات التي من شأنها تعزيز الثقافة الديمقراطية، لكن بحكم غياب الثقافة الديمقراطية لعقود في تونس عن مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، بفعل استيلاء بن علي على مقاليد الحكم لعقود، يترتب على الأحزاب والتيارات المختلفة مهمة توعية الجمهور المهلل بالانقلاب بأن ما يحصل مخالف للتطلعات الثورية وبأنه ليس لتصفية جهة واحدة من الحياة السياسية وإنما لتصفية الحياة السياسية الديمقراطية برمتها وجمع مقاليد الحكم في يد رئيس الجمهورية في انقلابه الذي يشبه انقلابات القصور.
تلفزيون سوريا
—————————
تونس وعداء “الإخوان” للجيوش!/ محمد صلاح
التطورات المتلاحقة في تونس كانت متوقعة، وكل من تابعوا أنماط العالاقات بين “الإخوان المسلمين” هناك وباقي مفردات المجتمع، انتظروا صداماً بين “حركة النهضة” والرئيس قيس سعيد، أو قل بين التنظيم والشعب. أما قرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ونقل معظم الصلاحيات الى الرئيس فتضع البلاد على المحك، وتختبر قدرة “النهضة” على تحريك الشارع، أو بمعنى أدق اللجوء الى العنف!
المؤكد أن الرهان في المرحلة التالية سيكون على موقف الجيش التونسي ومدى انحيازه الى الإرادة الشعبية، خصوصاً أن قرارات الرئيس سعيد أتت بعد مؤشرات الى عزم الإخوان على التصدي لاعتراضات الشارع وغضب الجماهير ضد سياسات “النهضة” وتصرفات زعيمها راشد الغنوشي، ناهيك بالتنكيل بالمعارضين والاعتداء عليهم وممارسة الاغتيال المعنوي ضد كل شخص يتصدى لسياسات “النهضة” أو يفنّد ادعاءات رئيس البرلمان، لكن المتابع أيضاً لتاريخ الإخوان وصداماتهم مع الحكومات والأنظمة والشعوب، يدرك تماماً مدى العداء الذي يحكم علاقة ذلك التنظيم وأذرعه بالجيوش، ولنا في مصر نموذج ربما يضع مؤشرات الى مستقبل الأوضاع في تونس. فبينما يضع مؤشر غلوبال فاير باور Global Firepower الجيش المصري بين أقوى الجيوش في العالم بعدد ضباطه وجنوده الذي يقترب من 400 ألف، ودباباته التي تتجاوز الـ700 دبابة، وطائراته الـ 1594، ستدخل بعد أيام عشرات الآلاف من الأسر المصرية ماراثون إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية، بمجرد إعلان نتائج المرحلة الثانوية من التعليم الأساسي. بالطبع فإن أخبار تفوُّق الجيش المصري في المؤشر العالمي يتم التعتيم عليها من وسائل الإعلام المتعاطفة مع تنظم الإخوان الإرهابي، مثل كل خبر أو حدث إيجابي يحدث في مصر أو للمصريين، بينما لا تتوقف الآلة الإعلامية الضخمة للتنظيم التي تعتمد بالأساس على التمويل القطري واللجان الإلكترونية لآلاف من عناصر الجماعة، وتغوص في ممارسة التحريض ضد الحكم وتخوض في نقاش يومي لا ينتهي حول ارتفاع الأسعار!! إلى مواصلة الحملة على الجيش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورغم تخصيصها مساحات كبيرة من الوقت للحديث عن نظام التعليم وشكاوى الطلاب والمدرسين، وكذلك مشكلة الغش في الامتحانات، لم تشر قط إلى ظاهرة الحرص على الالتحاق بالكليات العسكرية، بل تواصل محاولة الإساءة إلى الجيش، وتنتظر دائماً وقوع عمليات إرهابية في سيناء للترويج بأن ما يحدث هناك يعني تقصيراً، بينما القبض على الإرهابيين أو التصدي لهم وقتلهم يعني ظلماً للأبرياء وعدواناً على الحق في الحياة!!
ولا يمكن إخفاء حرص الأسر المصرية على إلحاق أبنائها بالكليات العسكرية، رغم المخاطر التي يتعرض لها الضباط والجنود في ظل حرب ضروس تخوضها مصر في مواجهة الإرهاب، ويدرك الجميع أيضاً أن الإرهاب تفجر منذ ظهور جماعة “الإخوان المسلمين” وتنظيمات أخرى تستخدم الدين وسيلة لتحقيق هدفها بإسقاط الأنظمة والحكومات والوصول إلى السلطة، وأن دولاً وجهات معادية لمصر تتحالف مع الإرهابيين وتستخدمهم وتنفق عليهم وتفتح أراضيها لإيوائهم ورصد أموال ضخمة لإنتاج أفلام ركيكة تسيء إلى الجيش وتسعى إلى النيل منه.
وليس سراً أن شرعية الرئيس السيسي المنتمي الى المؤسسة العسكرية تأسست على العداء لتنظيم الإخوان والتصدي لمؤامراته ومواجهة الإرهاب، بينما الرؤساء الذين سبقوه كانوا قد وصلوا الى الحكم ثم بعد ذلك دخلوا في صدامات مع الإخوان، ورغم أن السيسي واجه ذلك التنظيم وخلفه دعم شعبي هائل في 30 حزيران (يونيو) 2013، لكن تجدر الإشارة الى أن أحكام السجن والإعدام التي صدرت ضد قياداتهم في عصر الرئيس السيسي كانت من محاكم عادية، ولم تلجأ الحكومة الى محكمات عسكرية أو استثنائية، ومع ذلك لم ينفذ أي حكم بالإعدام بقيادات أو أعضاء من الجماعة، كما أن السيسي أعلن في مناسبات عدة أنه لا مجال لعودة كيان تنظيمي للجماعة أو غيرها من التنظيمات المتأسلمة التي وجدت في السنة التي حكم الإخوان فيها مصر فرصة لتحويل تنظيماتها المسلحة أحزاباً سياسية.
عموماً، فإن إقبال الشبان المصريين على الالتحاق بالجيش يثبت الفشل المزدوج للإخوان وحلفائهم، فرغم الهجوم الممنهج الذي يستهدف الجيش كانت النتيجة عكسية، ما يسبب دائماً صدمة كبيرة لهؤلاء الذين أنفقوا أموالاً طائلة من أجل كسر الجيش المصري وتشويه صورته أمام شعبه، ثم يظهر أن الإرهاب الذي يمارسه الإخوان والجماعات الأصولية الراديكالية لم يزد أبناء مصر إلا رغبة في الالتحاق بالجيش، الذي تصبّ في شرايينه، في مثل هذا الوقت من كل عام، دماء جديدة تعوّض غياب الشهداء وتتبنى القناعات والمبادئ نفسها التي صنعت عقيدة المؤسسة العسكرية، وربطت بينها وبين فئات الشعب في محافظات مصر ومدنها وقراها وأحيائها الراقية والشعبية والفقيرة. هنا تكفي الإشارة الى أن الأفلام التي تبثها القنوات القطرية والتركية عن الجيش المصري قوبلت بالسخرية من المصريين، الذين يحترمون الضباط والجنود ويقدرون تضحياتهم ويرفضون إهانتهم ويستنكرون تحقير فكرة الواجب الوطني، لكنّ أفلاماً كتلك أثبتت ما كان الشعب المصري توصل إليه، من أن الإخوان والدول والجهات الداعمة لهم يعتبرون الجيش حائطاً صلباً ضد أطماع الجماعة وأحلام داعميها.
يتعامل الإخوان في مصر وتونس وغيرهما من الدول العربية مع الجيش باعتباره منافساً للجماعة، ولذلك لا تتوقف منصات التنظيم عن التهكم على المؤسسات العسكرية والسخرية من الضباط والجنود مقابل الإشادة بالميليشيات أو الحرس الثوري، وما يزعج الإخوان ويسرّب اليأس الى عقول عناصرهم مشاهد الإقبال على الالتحاق بالخدمة العسكرية في هذه الدولة أو تلك، فقبل سنوات لم يكن سهلاً أن تمر في شارع العروبة شرق القاهرة في مواجهة مقر الكلية الحربية، حيث مكتب تنسيق الكليات العسكرية في مثل هذا الوقت من السنة، وكانت السلطات تضطر إلى إجراء تحويلات مرورية للتعاطي مع الازدحام الرهيب من شباب أتوا إلى المكان يحلمون بارتداء الزي العسكري. تغيّرت الحال الآن وأصبح تقديم طلبات الالتحاق بواسطة شبكة الإنترنت، لكن في مواعيد الاختبارات البدنية والطبية ظلت المشكلة قائمة، فالأعداد كبيرة رغم إعلام الإخوان وجرائم الإرهاب!!
النهار العربي
——————————
تونس: مطالبات بـ«خريطة طريق»
اختلاف على الهدف الرئيس يتعهد «حماية المسار الديمقراطي»
وترقب لحوار وطني يشمل «النهضة»
كمال بن يونس
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في العالم، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، المضي في «دعم المسار الديمقراطي التعددي»، وشددا على أن القرارات الاستثنائية «ظرفية» بهدف «التصحيح والإصلاح، وليس الانقلاب على الدستور أو عسكرة البلاد».
وفي حين تزايدت مطالبات القوى السياسية – على اختلاف مواقفها من إجراءات سعيد – بوضع «خريطة طريق»، إلا أنها اختلفت على الهدف النهائي لخريطة الطريق المطلوبة وسقف الإجراءات المرتقبة ومداها الزمني.
وعقد سعيد اجتماعات ماراثونية مع ممثلين عن منظمات المحامين والقضاة والصحافيين ونقابات رجال الأعمال والعمال والفلاحين لطمأنتهم إلى تمسكه بـ«المسار الديمقراطي»، وليفسر لهم مبررات تجميده البرلمان وإسقاطه حكومة هشام المشيشي وإعلانه نيته إحالة عدد من النواب المتهمين بالفساد على القضاء بسبب ملفات مفتوحة ضدهم منذ أعوام.
ونوّه نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة بعد اجتماعه مع الرئيس في قصر قرطاج بحضور شخصيات وطنية بـ«إرادة قيس سعيد لدعم الحوار السياسي الوطني في المرحلة المقبلة مع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، بما في ذلك قيادات حزب النهضة وبقية الأحزاب المعارضة».
وذكر أن الشخصيات السياسية الوحيدة التي ستستبعد هي تلك التي «تحوم حولها شبهات فساد» وبينها عدد من السياسيين وأعضاء البرلمانين الحالي والسابق، منهم من اتهم في قضايا تهريب وتهرب من الضرائب وتلقي رشاوى ودعم مالي من المشتبه فيهم مالياً وأخلاقياً.
– مطالبات بـ«خريطة طريق»
في الأثناء، نوه عدد من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس، بينهم الجامعية سلسبيل القليبي والحقوقية سلوى الحمروني والأكاديمي الصغيير الزكراوي، بالقرارات التي أعلنها قيس سعيد مساء الأحد والتي وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية في تونس وخارجها بكونها «انقلاباً على الدستور وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية».
لكن القليبي والحمروني والزكراوي وعدداً من زملائهم عارضوا ذلك التوصيف، مشيرين إلى أن القرارات «لم تؤد إلى تعطيل العمل بالدستور وتسليم الحكم إلى الجيش» على غرار ما جرى في الانقلابات التي شهدتها دول عربية وأفريقية سابقاً. كما رحب الخبير الاقتصادي المعارض جمال عويديدي بالقرارات، واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «كارثية وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد».
الشرق الأوسط
—————————
عودة الدكتاتور مع جمهور يصفّق له/ حسن عباس
عندما اندلعت ثورات الربيع العربي وأطاحت ببعض الحكام المستبدّين، كان هؤلاء قد بلغوا أرذل الأحوال شعبياً، فقد كانوا طيلة عقود يحكمون الناس بالقمع عموماً، وبالخبرة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، حيث كانت توجد هكذا استحقاقات.
الآن، مع الانقلاب* الذي نفّذه الرئيس التونسي قيس سعيّد، نشهد إرهاصات دكتاتور تونسي جديد سيأتي هذه المرّة مع ظهير شعبي عبّرت عنه التظاهرات المحتفية بقراراته، ما يعني أن عقداً من الزمن بعد الثورات التي عقد كثيرون عليها آمالهم من أجل مستقبل أفضل لم يفضِ سوى إلى “تجديد شباب الدكتاتورية”.
هذا ما كان قد حصل في مصر وكاد يحصل في ليبيا لولا عجر المشير خليفة حفتر عن السيطرة على طرابلس، وها هو يحصل الآن في “أفضل تجارب الربيع العربي” التي كان معظم المراقبين يستبعدون انحدارها إلى هذا الدرك.
الانقسام الحاد
في كل مكان حيث نجحت الدكتاتورية في تجديد شبابها أو كادت، هنالك انقسام حاد بين الإسلاميين ممثَّلين بشكل أساسي بجماعة الإخوان المسلمين وبين مراكز قوى معادية للإسلاميين تعتبر نفسها أكثر تنويراً منهم وتنسج قوتها من تراث حديث (زمنياً) معادٍ للإسلام السياسي ومن تقاطعات سياسية عابرة للحدود ومعادية للإسلام السياسي العابر بدوره للحدود.
يعتبر معادو الإسلاميين أن الغاية تبرر الوسيلة**. وإنْ كانوا يعتقدون محقّين بأن حركات الإسلام السياسي لم تحسم نهائياً مسألة ضرورة انتظام عملية تداول السلطة، إذ لا تزال ميوعة أدبياتها حول هذه المسألة وتناقضات قياداتها عندما يتحدثون عنها ورصد ممارساتها عندما تكون في مواقع متنفّذة تطرح مخاوف من أنها تعتبر الديمقراطية طريقاً جيداً للوصول إلى الحكم ولتمكين نفسها من حكم المجتمعات العربية ويمكن قطعه بعد ذلك، فإنّ معادي الإسلاميين ينحدرون إلى ما دون ذلك، إلى أساليب الحكم القديمة الصلفة، أي الدكتاتورية العارية.
غَضَب طيف واسع من التونسيين من الأوضاع العامة في بلدهم مفهوم جداً. 27% منهم عبّروا عن قلقهم من نفاد مخزونهم من الطعام قبل أن يتمكنوا من تدبّر موارد مادية لاقتناء المزيد، و25% قالوا إن طعامهم نفد بالفعل، حسب أرقام استطلاع أعدّه “الباروميتر العربي” في آذار/ مارس الماضي.
مع هكذا حال، بعد صبر عقد على قطف ثمار الثورة دون أن تنضج حتى، يصير مفهوماً سبب غضب الناس من حالة المراوحة ومن المناكفات السياسية التي يحمّلونها سبب تردّي أوضاعهم، ويصير مفهوماً سبب احتفاء البعض بقرارات سعيّد.
ولم ينسَ التونسيون بعد أن السياحة في بلدهم كانت أفضل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن بلدهم كان يحقق معدلات نمو جيدة، لم يحقق مثلها بعد الثورة، وأن نسبة البطالة كانت أدنى. هذه الذكريات ليست قديمة.
المشكلة التي لا حل لها والمرتبطة بالثورات هي أن الآمال المعقودة على نتائجها لا تكون مرتبطة بالواقع بل تكون متجاوزة له، ولعل هذا من شروط قيام الثورات، ولكن الواقع، في كل مكان، لا يسمح بتحقق كل شيء بل يعيدنا إلى دائرة ارتباط أي تقدّم يمكن إحرازه بمدى الإمكانات المتوفرة، خاصةً على صعيد الاقتصاد.
وفي العادة، تعجز الأنظمة الديمقراطية القائمة في دول نامية عن الاستجابة لتطلعات الشعب على صعيد خلق فرص عمل والطبابة وكافة الخدمات، ولكن الدكتاتوريات تعجز أيضاً مع فارق أنها تطعم الناس شعارات وإنجازات لا يرونها إلا على شاشات الإعلام الحكومي.
التفكير في التعددية
لا يمكن التعامي عن حقيقة أن التعددية السياسية تعقّد مسألة اتخاذ القرارات لا بل تعرقلها أحياناً وتحوّل السياسة إلى ميدان لتنصل القوى السياسية من المسؤولية وقذفها على آخرين. هذا لا يرتبط فقط بتونس أو بدولة مثل لبنان بل يمكن أن نراه في إسرائيل وفي إيطاليا وفي دول كثيرة. ولا يمكن التعامي عن أن هذا الأمر قد يرتدّ سلباً على معيشة المواطنين.
هنالك حاجة للتفكير في التعددية السياسية وعدم الاكتفاء بالتغنّي بها لكونها مؤشراً على وجود ديمقراطية، ولكن الملحّ هو التفكير في كيفية إدارة الأنظمة السياسية التعددية بشكل يمنع تعطيل آليات اتّخاذ القرارات ويتيح التخطيط طويل الأمد، وليس الانجراف إلى استنتاج أنها بطبيعتها سيئة. فالمشكلة هي في آلية اتخاذ القرارات وليس في فتح إمكانية لكافة الأطراف في المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم والانتظام سياسياً وفق ذلك.
وهنالك أيضاً حاجة للتفكير في إمكانية وجود ديمقراطية في دول تعاني من صعوبات اقتصادية، وهذه حاجة عالمية وليست محلية فقط، فالإنسان بطبعه يميل إلى تفضيل احتياجاته الأساسية على مسائل مثل حرياته، وعندما يعاني ولا ينجح في تصوّر حلّ، يميل إلى التعلّق بأي وعد، فيرمي بنفسه في أحضان الشعبويين، وكل سياسي شعبوي هو مشروع دكتاتور.
طريق مسدود
الدكتاتورية ليست الحل ولا يمكن أن تكون الحل. والمسألة ليست تفضيلات جمالية. الدكتاتورية طريق مسدود قد ينتج عنه تحسن في الأوضاع الاقتصادية، وقد ينتج عنه أيضاً انهيار اقتصادي، وسينتج عنه حكماً خنق للحريات. ومشكلة هذا الطريق الأساسية هي في عدم وجود آلية سلمية للتراجع عنه. الديمقراطية وتداول السلطة، برغم كل هنّاتها، تترك هذا الطريق سالكاً، على الأقل نظرياً، وتترك عملياً أدوات لمعاقبة الأحزاب وتترك الاحتمالات مفتوحة على تشكّل أطر جديدة، يعني تسمح للمواطنين بأن يكونوا جزءاً أساسياً من العملية السياسية وجزءاً مشاركاً في الشأن العام، أو على الأقل تتيح لهم هذا الاحتمال.
لا ضمانات للمواطنين غير القوانين والدساتير. إما هذا وإما العيش وفق مزاج الدكتاتور. الحياة في ظل حكم القانون قد لا تكون نعيماً ولكن المؤكد أن العيش بدونه يحوّلنا من بشر لهم حقوق إلى كيانات تسير كالقطيع، على إيقاع جرس الدكتاتور.
لا تزال الفرصة أمام عودة تونس إلى المسار الديمقراطي سانحة، ولا يزال ممكناً أن تذكر كتب التاريخ ما جرى كـ”محاولة انقلابية” أفشلت أو جرى التراجع عنها. المكاسب التي راكمها التونسيون خلال العقد الماضي على صعيد الحريات لا ينبغي التضحية بها مقابل أمل لن يصدق بأن الدكتاتورية ستكون أفضل لأنها لن تكون.
ـــ
*لماذا ما حصل هو “انقلاب”؟ يمتنع كثيرون عن استخدام مصطلح “الانقلاب” لوصف ما جرى في تونس. ما جرى أن الرئيس قيس سعيّد اتخذ قراراته بتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة متذرعاً بالمادة 80 من الدستور رغم أن نص المادة واضح جداً لجهة أن “التدابير الاستثنائية” التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلاله” لا يمكن أن تتضمن لا تجميد عمل البرلمان ولا إقالة رئيس الحكومة فالمادة نفسها تشترط اتخاذ هذه التدابير باستشارة رئيسي الحكومة ومجلس النواب. والمادة نفسها أيضاً، وحرصاً منها على حسن سير عمل المؤسسات الدستورية، وهو أمر ضروري بشكل خاص في الفترات الاستثنائية، نصّت بوضوح على أنه “يُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”، وعلى أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب” وأنه “لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”، وهي الصلاحية الوحيدة التي يمتلكها الرئيس في ما خص إقالة الحكومة، وهي فعل محصور بمجلس النواب، ما عدا في حالة وحيدة: إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (لرئيس حكومة بعد الانتخابات النيابية) ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة.
لهذه الأسباب هو “انقلاب” أو على الأقل هو “محاولة انقلابية” لأن الأمور لا تزال مفتوحة على العودة عن القرارات المتخذة وإعادة عمل المؤسسات الدستورية.
**في إعلانه لقراراته، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد “نحن نعمل في إطار القانون”، ولكنه أضاف: “إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحوّل القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقَّر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبّر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب”، يعني يعطي لنفسه الحق بتفسير القوانين لا بل يعطي لنفسه الحق بالقول إنها غير مناسبة إذا كان هو يراها كذلك.
رصيف 22
————————-
البرلمان يجتمع “أونلاين”… النهضة تتحدى قرارات قيس سعيد/ هاجر عبيدي
تزامنا مع العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أشهر من مطالباته المتكررة بتعديل الدستور التونسي لمنحه المزيد من السلطات، أعلنت حركة النهضة التونسية تشبثها بموقفها الرافض لهذه القرارات، التي تعتبرها “انقلابا على الشرعية وتجاوزا صارخا للدستور”.
وخلال الساعات الأولى من بدء سريان قرارات سعيد بعد استعانته بالجيش التونسي، أصدرت الحركة بيانا تدعو فيه رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد “ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي”، مشددة على ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا وفق تعبيرها.
وأوضح النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي لرصيف22، أن مكتب المجلس لم يبت في اجتماعه الأخير الذي انعقد أمس الإثنين، 26 يوليو/ تموز، في مسالة استكمال نشاطه عن بعد. إلا أن مصدراً من الحركة قال لرصيف22 بشرط عدم الإفصاح عن اسمه، أن البرلمان قرر مواصلة العمل استنادا للفصل 51 من الدستور، الذي يخول للمكتب الاجتماع خارج مقره.
وينص الفصل 51 من الدستور على أن ” مقرّ مجلس نواب الشعب، تونس العاصمة. وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية”.
من جانبه عبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة له عن تشبثه وأعضاء كتلته بـ”صفاتهم وبرلمانهم” الذي انتخبه الشعب التونسي، معرباً عن استعداداهم “النضال من أجل حرية الشعب”.
كما أكد أن “أحرار تونس وحرائرها جاهزون للعودة للنضال، وتتبع كل من ستسوّل له نفسه إيذاء أي تونسي أو تونسيّة… أو المس من الحريات الأساسيّة أو حقوق الإنسان… أو التلاعب بالمال العام وبمقدّرات الشعب التونسي”.
وجاءت تلك التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين عن فرض حالة الطوارئ المشددة في عموم البلاد، وذلك بفرض حظر التجوال المشدد من السابعة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي (بتوقيت تونس)، وحظر اجتماع أكثر من ثلاثة أشخاص، وحظر انتقال الافراد والمركبات بين المدن في كافة الأوقات، عدا حركة السلع الأساسية وللظروف الصحية. بالإضافة إلى إيقاف عمل الإدارات العامة في تونس بكافة الوزارات والهيئات لمدة يومين قابلين للتمديد.
————————-
=====================
تحديث 29 تموز 2021
————————
الانقلاب الرئاسي على الدستور في تونس.. ظروفه وحيثياته ومآلاته
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الأحد 25 تموز/ يوليو 2021، عزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولّيه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومةٍ يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، ورئاسة النيابة العمومية، وتجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن النواب. وجاءت قرارات سعيّد، التي مثلت انقلابًا على الدستور، عقب يومٍ شهد مظاهراتٍ وأعمالَ شغب في عدد من المدن، شملت الاعتداء على مقرّات حركة النهضة في بعض المدن؛ لتكون ذريعةً استخدمها الرئيس للاستئثار بالحكم، وتبدو خطوته كأنها ضد حركة النهضة، مع أنها تأتي في سياق صراعه مع مجلس النواب منذ توليه الحكم، وليس مع حركة النهضة.
خلفيات الأزمة وأسبابها
لم تكن القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، مساء الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري، منفصلةً عن سياقات الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس منذ سنتين، فإثر الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية التي شهدتها البلاد، أواخر 2019، وجاءت بسعيّد رئيسًا للجمهورية، ومنحت حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية من دون أغلبية، بدأ الصراع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، من جهة، وكل من مجلس النواب والحكومة، من جهة ثانية، يظهر إلى العلن. وتصاعدت التجاذبات إثر اختيار الرئيس سعيّد هشام المشيشي لرئاسة حكومةٍ تخلف حكومة إلياس الفخفاخ، ثم تراجعه السريع وطلبه من كتل مجلس النواب عدم منح الثقة للفريق الحكومي، بعد أنْ أبدى المشيشي تمسّكًا بصلاحياته الدستورية في اختيار أعضاء الحكومة ورفضه أداء دور “وزير أوّل” لدى سعيّد؛ فليس النظام التونسي رئاسيًّا.
تعمّقت الأزمة بين الطرفين، إثر التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على فريقه الحكومي وقد استبعد، بمقتضاه، الوزراء المحسوبين على سعيّد؛ وهو التعديل الذي قابله سعيّد بالرفض والامتناع عن دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، على الرغم من أن مجلس النوّاب منحهم الثقة، بتعلّة أنّ بعضهم يُشتبه في فساده. وهذا ليس من صلاحيته؛ فتُهم الفساد، وليس الشبهة، إنّما يحسم فيها القضاء، كما أنّ أداء اليمين، بعد منح الثقة في مجلس النواب، إجراء شكلي لا يجوز استخدامه لعزل وزراء منَحهم هذا المجلس ثقته. وإثر ذلك، كرّس سعيّد قطيعته مع الحكومة وكتل مجلس النواب التي تدعمها برفض التصديق على قانون تعديل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذي أجازه مجلس النواب نفسُه بأغلبيةٍ مريحة، ثم بإعلان نفسه قائدًا أعلى للقوات المسلحة المدنية (الشرطة، والحرس الوطني، والجمارك)، إضافةً إلى صفته الدستورية قائدًا أعلى للجيش.
وفي خضم هذه الأزمة، لم تكن أغلبية مجلس النواب حاكمةً، بل إنها كانت داعمةً لحكومة تكنوقراط، وانشغلت الأحزاب في صراعاتها من دون أن تلتفت إلى امتداد الرئاسة التدريجي إلى صلاحيات الحكومة ومجلس النواب، كما سمح وجود حزبٍ مؤيدٍ للنظام القديم ومُعادٍ للثورة وللديمقراطية، يقوم عمليًّا بالتهريج خلال جلسات مجلس النواب، بتصوير هذا المجلس مكانا فاقد الصلة بواقع الناس وحياتهم اليومية؛ ما أسهم في تعزيز الخطاب الشعبوي للرئاسة والموجَّه ضد الأحزاب ومجلس النواب.
التحضير للانقلاب الرئاسي
على وقع الأزمة السياسية/ الدستورية المتصاعدة بين رئيس الجمهورية ورئيسَي الحكومة ومجلس النواب، تواترت على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الأخيرة، دعوات للتظاهر يوم الأحد 25 تموز/ يوليو؛ الذي يصادف عيد الجمهورية، للمطالبة بحل مجلس النواب، وإقالة الحكومة، ووقف العمل بالدستور، وإلغاء النظام السياسي والقانون الانتخابي الحاليَّين، ومعاقبة السياسيين؛ خصوصا من حركة النهضة، وعسكرة الإدارة، والدخول في مرحلة انتقالية يشرف عليها الرئيس قيس سعيّد. وعلى الرغم من أنّ الصفحات التي تولّت ترويج هذه الدعوة، والتي لقيت منشوراتها تغطية مكثفة من قنوات فضائية تبثّ من الإمارات ومصر، لم تكشف عن هوية سياسية أو حزبية واضحة، فإنها أجمعت على استثناء الرئيس سعيّد من منظومة الحكم التي تطالب برحيلها، وكأنه ليس أحد السياسيين.
وبالفعل، شهد يوم الأحد 25 تموز/ يوليو خروج مجموعات من المحتجين أمام مبنى مجلس النواب وفي عدد من المدن؛ أهمها سوسة، وتوزر، والقيروان، وصفاقس، ونابل. وعلى الرغم من أن عدد المتظاهرين لم يكن كبيرًا، فإن بعض التحرّكات شهدت أعمال عنف دارت، جلّها، حول مقرّات حركة النهضة؛ إذ عمد المحتجون في مدينة توزر، جنوب غرب البلاد، إلى اقتحام المقر وإتلاف محتوياته، في حين نزع المتظاهرون في القيروان وسوسة لافتاته. أمّا في العاصمة، فقد حاول متظاهرون الاقتراب من المقر المركزي لحركة النهضة، إثر إعلان قرارات الرئيس سعيّد، غير أن شرطة مكافحة الشغب منعتهم من ذلك. ويبدو أن المشهد كان مخططًا لكي يبدو صراع الرئيس على الصلاحيات مع مجلس النواب صراعًا مع “النهضة” لتسهيل استيلائه على صلاحيات هذا المجلس ضمن نظام برلماني في جوهره.
تبرير الانقلاب على الدستور
دعا قيس سعيّد مجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية إلى اجتماع طارئ في قصر قرطاج، مساء الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري، وأعلن، في ختام الاجتماع: “اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ الدولة والمجتمع بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب”. وتمثّلت القرارات المعلَنة في “تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه”، و”تولي رئاسة النيابة العمومية”، و”تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية”، مؤكّدًا “إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي فورًا ودعوة شخص آخر ليتولى رئاسة الحكومة، على أن يكون مسؤولًا أمام رئيس الجمهورية الذي يتولى بنفسه تعيين أعضاء الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء”. وتوعّد سعيّد “أي شخصٍ يتطاول على الدولة وعلى رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة”، بـ “مجابهته بوابل من الرصاص”، متّهمًا خصومه بـ “النفاق والغدر والسطو”.
وإثر الكلمة التي ألقاها سعيّد في الاجتماع الأمني والعسكري، نشرت رئاسة الجمهورية جملة القرارات المعلَنة باستثناء تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، كما تمّ تحديد مدة تجميد اختصاصات مجلس النواب بثلاثين يومًا. وفي اليوم التالي، أصدر سعيّد أوامر رئاسية بعزل وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، إضافة إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتعطيل العمل في الإدارات العمومية يومين قابلين للتمديد، وحظر التجوال الليلي شهرا، ومنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص.
أعلن سعيّد أن القرارات المتخذة تستند إلى الفصل (المادة) 80 من دستور الجمهورية التونسية، الذي ينص على ما يلي: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لشؤون الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”، كما ينصّ على أن مجلس نواب الشعب “يُعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”، وعلى أنه “في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”. لكن سعيّد خالف بوضوح نص هذه المادة؛ فبدلًا من أن يقوم باستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، أقال الأول وجمّد عمل الثاني. ثمّ إنّ المادة المذكورة لا تنصّ على تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية؛ ما يعني وضع السلطة القضائية تحت سلطته.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور “أن اللجوء إلى الفصل 80 في الوضع الحالي لا معنى له، بل هو يخالف تمامًا وبشكل صريح مقتضيات الدستور التونسي، لغياب الشروط الجوهرية والشكلية”. على مستوى الشروط الجوهرية، أكّد على عدم وجود خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة. أما على مستوى الشروط الشكلية، فأكد على ضرورة التحقق من استشارة رئيس الجمهورية رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب، كما أشار إلى أن الرئيس لم يقم بإعلام رئيس المحكمة الدستورية، نظرًا إلى عدم وجوده، ما يمنع من الاستناد إلى الفصل 80 من الدستور التونسي.
ورأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب “لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية”. وأضافت أن الفصل 80 ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته. وأوضحت الجمعية في بيانها “إن حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات”. كما أعلنت عن مخاوفها من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية.
إجماع على رفض الانقلاب
ما إنْ أعلن الرئيس سعيّد قراراته حتى عبّرت الأحزاب التونسية، على اختلاف توجهاتها الحزبية والأيديولوجية، باستثناء حزبَين، عن رفضها لها، في حين تحفّظت المؤسسات المدنية الكبرى عنها، ورفض أغلب القانونيين التونسيّين تفسيرات الرئيس للدستور. وقد اعتبرت حركة النهضة ما جرى “قرارات لا سند لها من القانون والدستور”، ووصف رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، الخطوة بأنها “انقلاب على الدستور والثورة والحريات العامة والخاصة”، مؤكدًا أنّ “مجلس النواب قائم وفي حالة انعقاد دائم”، وأنّ الرئيس سعيّد استشاره في تمديد حالة الطوارئ، وأنّ الاستشارة لم تكن متعلقةً بالإجراءات المعلَنة.
وجاء موقف ائتلاف الكرامة منسجمًا مع موقف حركة النهضة، حيث عَدَّ الائتلاف قرارات سعيّد “انقلابًا خطيرًا وفاضحًا على الشرعية الدستورية”، مُبديًا “رفضه المطلق لكل القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية”، و”استغرابه العميق من توظيف المؤسستين العسكرية والأمنية لتعطيل عمل المؤسسة البرلمانية”. أما حزب التيار الديمقراطي، فقد تحاشى وصف قرارات سعيّد بالانقلاب، غير أنه قال إنه يختلف مع تأويل “رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور”، وإنه “يرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور”. أما حزب العمال (يساري)، فقد وصف قرارات سعيّد بأنها “خرق واضح للدستور”، واعتبر أن الإجراءات المعلنة تجسّد “مسعى قيس سعيد، منذ مدة، إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه، وتدشّن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد”. أما الحزب الجمهوري التونسي فقد عدّ قرارات الرئيس “خروجًا عن نص الدستور وانقلابًا صريحًا عليه، وإعلانًا عن العودة إلى الحكم الفردي المطلق، وحنثًا باليمين التي أدّاها رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور”.
وانفردت حركة الشعب (حزب قومي) بتأييد القرارات التي أصدرها الرئيس سعيّد، واعتبرتها “طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادّة لها، وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي اجتمع أمينه العام إلى الرئيس سعيّد عقب إعلان الإجراءات الأخيرة، فقد اتخذ موقفًا متحفظًا؛ إذ أبدى مساندته “التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات”، مُنبّهًا إلى “ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد”.
صعوبات تواجه انقلاب الرئيس
حتى الآن، لم يُسمِّ الرئيس الشخصية التي ستخلف المشيشي في رئاسة الحكومة. ويؤشّر هذا التأخير إلى إمكانية بروز صعوبات في الاختيار، خاصة أن الشخصية الجديدة ستكون بمنزلة موظف عند الرئيس الذي يريد أن يدير بنفسه عمل الفريق الحكومي، وذلك مع الخشية من الوقوع في مزيد من الإخلالات الدستورية بشأن منح الثقة للفريق الحكومي في ظل تجميد عمل مجلس النواب.
كذلك، يواجه سعيّد صعوباتٍ في تمرير قرارات أخرى؛ إذ رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الرئيس تولي رئاسة النيابة العمومية، مؤكِّدًا “استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية”، ومؤكّدًا، عقب اجتماع بعض أعضائه بالرئيس، أن “النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي”. ويضاف إلى ذلك الموقف الغالب لمعظم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وهو موقفٌ داعٍ إلى ضرورة احترام الدستور، والتقيد بالآجال المحدّدة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وبسبب ردود الأفعال هذه، التي أكّدت، في معظمها، عدمَ دستورية القرارات التي اتخذها الرئيس، بدأت تتراجع حالة الاندفاع التي ميّزت سلوك أنصار الرئيس سعيّد، في البداية، وآمالهم في توظيف المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية للتخلص السريع من خصومهم، بالاعتقالات والسجون. فلم تسجل حتى الآن أيّ اعتقالات، واكتفت قوات الأمن بتفريق متظاهري الطرفين أمام مجلس النواب، في حين اقتصر انتشار الجيش على مدخلَي قصر الحكومة في القصبة ومجلس النواب؛ حيث مُنع رئيسه راشد الغنوشي وأعضاؤه من الدخول في اليوم التالي لإعلان قرارات الرئيس، وبرّر الضباط قرار المنع بتطبيق “تعليمات عليا”، في إشارة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة التي يتولاها قيس سعيّد.
ولم يصدر أي موقف رسمي عن المؤسسة العسكرية مما يجري، غير أن إعلان سعيّد قراراته بحضور القيادات العليا للجيش والأمن قد يؤشّر إلى أنه ضمن موافقتها قبل أن يُقدم على إجراءات وقف الحياة الدستورية. وعلى الرغم من ذلك، تظل موافقة المؤسسة العسكرية، في حال حصولها، معطىً غير كافٍ للجزم بتغير في السلوك الذي طبع تعاطيها مع الأحداث منذ ثورة 2011، والذي تميز بالنأي عن التجاذبات السياسية، أو الجزم بأنّ الأمر يتعلق بمجرّد تطبيق لتعليمات القيادة العليا للجيش؛ ممثلة في الرئيس سعيّد، بمقتضى التراتبية والانضباط العسكري، أو الانخراط في ما يجري والتحول إلى لاعب جديد في المشهد السياسي التونسي، وإنْ كان هذا الأمر غير محتمل، بدليل إقالة وزير الدفاع بالأمر الرئاسي نفسه الذي أُقيل به رئيس الحكومة.
لا تمثّل معطيات الداخل المؤشّر الوحيد إلى مآلات ما يجري في المشهد السياسي التونسي؛ إذ يظل الموقف الإقليمي والدولي عاملًا آخرَ مهمًّا في نجاح الانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس أو فشله. ولعل موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الإسراع في العودة إلى الحياة الدستورية، واستئناف نشاط مجلس النواب، والموقف الأميركي المؤكّد على حلّ المشاكل بالاستناد إلى الدستور، تُعدُّ كلّها مؤشّراتٍ دالّة على عدم وجود رغبة دولية في إفشال التجربة الديمقراطية التونسية، وضرب استقرار البلاد في أثناء ذلك. وقد بدَا الموقف الأميركي أشد وضوحًا من الموقف الأوروبي، وهو الأشدّ قدرة على التأثير في الجيش التونسي. ولكن المواقف الدولية لن تدافع عن التجربة التونسية إلا إذا خرجت القوى الحزبية والمدنية التونسية بموقفٍ قويّ وموحّد معارض للانقلاب على التجربة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية.
خاتمة
بعد مرور أيام قليلة على الانقلاب الذي قاده الرئيس على الدستور، وتصاعد الأصوات الداخلية والخارجية الداعية إلى سرعة العودة إلى الحياة الدستورية والمؤسّساتية وحماية الحرّيات وحقوق الإنسان، بدأت تظهر مؤشّرات ترجّح نشوء صعوباتٍ أمام سعيّد في استنساخ السيناريو المصري وإعادة إنتاج منظومة الاستبداد. لا شك في أن الشعب التونسي يعاني مشاكل اقتصادية صعبة، زادَ من حدّتها عجزُ الديمقراطية التونسية الناشئة عن تلبية التوقعات في حلّها بخطط تنموية ناجعة. كما أن التكتيكات الحزبية المفرطة والمماحكات الحزبية وتراشق التهم ورغبة المعارضة في إفشال الحكومة بأي ثمن في مرحلة صعوباتٍ اقتصاديةٍ حادّة أسهمت، كلّها، في زيادة حدّة الفشل وخيبة الأمل لدى الشارع؛ في ما يتعلّق بالحلول العملية لمشكلاتهم الاقتصادية. لكن ذلك كله لا يبرّر التراجع عن المكتسبات الديمقراطية الكبيرة التي حققها الشعب التونسي على مدى العقد الماضي، أو السماح لرئيسٍ لا يمتلك أيّ سجلٍّ مهني بارز أو نضالي أو سياسي بإطاحة هذه الإنجازات والتحريض بخطاب شعبوي يدّعي الترفّع عن السياسة لإعادة إنتاج منظومة الاستبداد.
الديمقراطية في حد ذاتها هي حلٌّ لآفة الطغيان وضمان لحقوق المواطن، وليست حلًّا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فهذه وظيفة القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات الحكم، وذلك في إطار النظام الديمقراطي الذي يجب الحفاظ عليه؛ لأن البديل هو الاستبداد الذي يقمع الحريات، ولا يُقدّم حلًّا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
—————————–
تونس… ثورة مضادة فوق صفيح ساخن/ بشير البكر
الخامس والعشرون من يوليو/تموز يوم مفصلي في تاريخ تونس. شهد ذلك اليوم في عام 1957 انتقال البلاد من الملكية إلى الجمهورية، بعد عام ونصف العام من الاستقلال عن فرنسا. وصعد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى رئاسة الجمهورية التونسية الأولى، التي أنهت حكم محمد الأمين باي، آخر سلالة “البايات” التي حكمت تونس بين 1705 و1957. وبعد 64 عاماً، يعود هذا اليوم إلى مفكرة الأحداث عبر الانقلاب الذي قام به رئيس الدولة قيس سعيّد على كامل المؤسسات الدستورية في عيد الجمهورية. والربط هنا ليس مصادفة، بل هو مدروس، وأراده سعيّد انقلاباً كامل الأوصاف على العهود السابقة، غير مكترث بأنه قام على خرق صريح للدستور، ووضع من خلاله يده على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
دولة تونسية جديدة. جمهورية أخرى تولد على قاعدة من الشعبوية، شبيهة بالشعبويات التي سبق أن قام بعضها في المنطقة وخارجها، وانتهت بالبلد منهاراً ومحطماً، تتنازعه الأزمات والمصاعب المزمنة، على غرار فنزويلا هوغو شافيز، ليبيا معمر القذافي، والبرازيل في وضع الرئيس الحالي جايير بولسونارو… إلخ. رئيس تونس أصدر فرماناته ليل الأحد، وترك الشارع لأبناء شعبه الذين دشنوا ثورات الربيع العربي يتراشقون بالحجارة أمام البرلمان صباح اليوم الثاني للانقلاب، بينما جلس هو في قصر قرطاج ليكمل حياكة بقية الحكاية، التي فاجأت الجميع بمدى تداخل خيوطها التي نسجها منذ وصوله إلى الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 من خارج عالم السياسة التونسية المعروف، والتي تعامل معها على أنها لعبة مبتذلة، ومهنة للفاسدين الذين لا مهنة لهم.
جاء ناضجاً رد فعل الأحزاب السياسية التونسية قاطبة، ولم يؤيد الانقلاب أي طرف سياسي ذي وزن، بما في ذلك حزب العمال الشيوعي الذي يعد ألد أعداء حركة “النهضة”، أكثر طرف استهدفه الانقلاب، بينما كانت المفاجأة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يقف ضد الانقلاب، وهو الذي شكّل عامل توازن خلال فترات مفصلية من تاريخ تونس، ومن ذلك الثورة ضد نظام الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي في نهايات ديسمبر/كانون الأول 2010، حين رجح كفة انتفاضة الشارع بوجه جهاز أمن بن علي. وخلال عشرية الثورة تدخّل الاتحاد عدة مرات من أجل تصحيح المسار، ولم يكن على وفاق مع قيس سعيّد الذي رفض الرد على مبادرات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الذي كان يتشاور معه باستمرار، وانقطع حبل الود بينهما منذ عدة أشهر.
فرنسا الأم الحنون لتونس بقيت صامتة طيلة نهار الانقلاب، وصدر عنها موقف غير ذي قيمة في وقت متأخر، وهي التي تعرف تونس أكثر من بعض مدنها. ونظراً للعلاقات الأمنية الوثيقة والتعاون المديد بين البلدين، الذي يعود إلى عقود طويلة، لا يحصل حدث في تونس صغير أو كبير، ولا يكون لقصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) دراية مسبقة ورأي فيه. والرئيس إيمانويل ماكرون مثله مثل أسلافه من رؤساء فرنسا لم يشذ عن القاعدة، وبقي منشغلاً بشؤون البلد الصغير، حتى أنه أوعز للأجهزة الفرنسية في الآونة الأخيرة لتصنيف تونس على القائمة البرتقالية لوباء كورونا، على الرغم من أن البلاد تمر بحال من الانهيار الصحي. وأراد من ذلك أن يوجّه رسالة تضامن من خلال حث السياحة الفرنسية لتقصد تونس التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة.
الوصفة التي تم تجهيزها قبل عقد من الزمن، هي ذاتها التي جرى تطبيقها في تونس بنسخة منقحة من الثورة المضادة، وحصل تغيير بعض القواعد في رقعة الشطرنج، وسط حالة تذمر داخلي واسعة كانت تضغط باتجاه حصول حدث دراماتيكي، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتفشي وباء كورونا في الشهرين الأخيرين. ومهما كانت التداعيات الداخلية، فإن التدخل الخارجي لعب دوراً كبيراً في تغذية الاستقطاب السياسي الحاد في تونس خلال العقد الأخير، ولعب إعلام الثورة المضادة دوراً أساسياً في تحريك الشارع ضد التجربة الديمقراطية. لم يقتصر الأمر على شيطنة حزب “النهضة”، بل واجه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي حرباً مفتوحة طيلة الفترة التي جلسها في قصر قرطاج، ولعبت الدعايات الداخلية والخارجية، وأموال تغذية الحروب الداخلية، دوراً كبيراً، في تقويض أول تجربة عربية في الديمقراطية والربيع العربي، الذي لا يزال يزعج الثورة المضادة، ويشكّل أهم حدث عربي بعد الاستقلال.
قد يبدو الانقلاب نزهة للبعض، إلا أن تعطيل المسار الديمقراطي الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة، سيضع تونس في ورطة فعلية، من خلال تجميد أهم سلطة في البلد وهي البرلمان، الذي يكرّس الإرادة الشعبية. وربما تكون هناك مآخذ كثيرة على الأداء البرلماني طيلة فترة الثورة، ولكن لا ديمقراطية من دون برلمان. البرلمان هو المكان الوحيد للاختلاف والاتفاق والتشريع، وسعيّد الذي جمّد في أول فرمان له هذه المؤسسة التي وضعت دستور عام 2014 المثالي، لم يقدّم خلال فترة حكمه مبادرة برلمانية واحدة وازنة، من أجل حل الأزمة داخل المؤسسة التشريعية، التي صانت تونس من الانزلاق إلى الحكم الفردي والدكتاتورية، وشكّلت صمام الأمان للتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، وهي من أهم إنجازات الثورة.
الانقلاب لن يقود سوى إلى تخريب التجربة، لا سيما أن هدفه هو بناء نظام ينسجم مع تيار الثورة المضادة. وعن هذا الطريق تدخل تونس اليوم النفق، وعليها أن تواجه في قادم الأيام القريبة جملة من الإجراءات غير الدستورية التي تعكس توجهاً نحو الحكم الفردي، وتجميع السلطات بيد واحدة في مخالفة صريحة للفصل 80 من الدستور، بذريعة “هذا ما يريده الشارع”، والترويج لالتزام المؤسسة العسكرية الحياد، في الوقت الذي سبق فرمانات سعيّد اجتماعه، علانية، مع قادتها، وبالتالي، فإن ما حصل نتيجة لطبخة متقنة، وليس وليد الأمس. وهناك مخاطر كبيرة تترتب على زج المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي، وهو ما لم يقدم عليه حتى بن علي الذي كان قائداً أعلى للجيش حين هددت الثورة الشعبية نظامه، ولم يوجّه أمراً بالتدخّل للجيش الذي تصرف عام 2011 بوصفه جيشاً جمهورياً في خدمة الوطن وليس الحاكم. وفي رأي أوساط سياسية تونسية، فإنه من المستبعد أن يكون هناك عنف بين المدنيين والجيش التونسي. وباعتبار أن قيس سعيّد لا يتمتع بحزام سياسي متين، فإنه سيعول على الجيش والأمن، وهذا غير مضمون، واحتمال تحوّله إلى رئيس ضعيف بيد هذه المؤسسة وارد جداً، وكما حصل في أواخر حكم بورقيبة في النصف الأول من الثمانينيات استطاع الجيش أن يتسلل إلى الحكم بقيادة الجنرال بن علي، الذي قام بانقلاب قصر على بورقيبة، وحكم تونس من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 حتى 14 يناير/كانون الثاني 2011.
المغرب العربي لم يعد شغالاً على ما يبدو. ليبيا معطّلة بسبب وضعها الخاص. والمغرب نأى بنفسه. والجزائر كان لها كلمة فيما يحصل في تونس، لكن كلمتها غير مسموعة هذه المرة، هي التي لطالما كانت عنصر توازن مع فرنسا التي كانت تجرّ تونس الصغيرة إلى طرفها، بعيداً عن محيطها الطبيعي داخل المغرب العربي الكبير، الذي عمل في وقت سابق، من أجل وضع سياسات تقارب وتعاون في وجه الهيمنة والأطماع، التي ظل يمارسها الاستعمار القديم لهذه المنطقة، التي تشكل بوابة وسياج قارة أفريقيا.
العربي الجديد
————————
جمهور قيس سعيّد وإهمال الخائفين من التغيير/ إيلي عبدو
بمعزل عن تسمية ما حصل في تونس، إنْ كان «انقلابا على الديمقراطية» أو إجراءات استثنائية، اتخذها الرئيس قيس سعيّد لـ»لإنقاذ البلد»، فإن سابقة خطيرة حصلت، في الديمقراطية الناشئة، تمثلت بتعطيل المؤسسات، والاستعانة بالجيش لفرض واقع سياسي جديد. وسواء تطورت هذه السابقة إلى انقلاب كامل، نتج عنه، عزل قوى سياسية أبرزها، حركة النهضة أو بقيت في إطار محدد يسفر عن حكومة جديدة وانتخابات نيابية مبكرة بقبول القوى السياسية، فإن الملاحظة الأبرز، في كل ما وقع، هي وجود أعداد كبيرة تؤيد قرارات سعيّد.
وهؤلاء تجاوزوا تونس نفسها نحو بلدان عربية أخرى، مع فارق أن في تونس، انحاز كثر لإجراءات الرئيس، انطلاقا من يأسهم من الطبقة السياسية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وخروج وباء كورونا على السيطرة، لكن خارج تونس، كان التأييد انطلاقا من معاداة الإسلام السياسي وتحديدا حركة النهضة، ضمن تعميم لا يلحظ الفروقات، ويصوب على الإسلاميين بصرف النظر عن أدائهم السياسي.
والمتحمسون لسعيّد، من توانسة وعرب، ليسوا مفصولين عن مناخ شعبي واسع، إذ إن تردي الأوضاع الاقتصادية وسلوك الإسلاميين السيء (مصر نموذجاً) مع إضافة الحروب الأهلية في بلدان المشرق وليبيا، عقب الانتفاضات العربية، كانوا وراء تنفير عدد كبير من الربيع العربي، فتم تفضيل الأمن والاقتصاد وعدم التهديد الوجودي على الديمقراطية.
صحيح أن هذه العناصر تخلو من أي معنى في ظل الاستبداد، بل على العكس، تنقلب إلى نقيضها، فبخصوص الأمن، الجميع مهددون بالاعتقال ضمن قوانين الطوارئ، وبخصوص الاقتصاد، الجميع مهددون بفقدان عملهم بسبب السيطرة السلطوية على الاقتصاد، والفشل في إدارته، لكن الصحيح أيضا أن هذا الجمهور، بنى، شروط حياته، بفعل الاستبداد، بمعزل عن السياسة، وصارت الأخيرة تهديدا له بدل أن تكون مدخلا لإعادة صياغة علاقته مع السلطة.
وما زاد الأمور تعقيداً أن منظري الثورات العربية أسقطوا من حساباتهم وجود قطاعات تتضرر عادة من التغيير، ولا بد من مدّ الجسور معها، وترميم علاقتها مع السياسة تدريجياً، بتطمينات وعروض تضمن لها مصالحها على العكس جرى أبلسة الجماهير الكارهة للربيع العربي ووصمها بالتشبيح، وتأييد الأنظمة السابقة، وهو ما عمّق الفجوة بين التغيير وبين الخائفين منه، وكشف عن تبسيط في التعامل مع الانتفاضات، بوصفها شيئا حتميا يمر دون تحديات تتصل بالمجتمع وتركيبته.
ثمة من ينظر لسعيّد على أنه «منقذ»، من أوضاع اقتصادية سيئة وشلل في إدارة المرحلة الانتقالية في تونس، وهناك من ينظر لعبد الفتاح السيسي بوصفه «ضمانة» لعدم عودة الإسلام السياسي للسلطة في مصر، هؤلاء، يضاف إليهم جماعات في المشرق تخشى على وجودها عند إحداث أي تغيير، فات أوان إقناعهم بالتغيير. والخشية، أن يكونوا قد باتوا أكثرية، بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار والحروب الأهلية وفشل المراحل الانتقالية.
والأرجح أن سبب ذلك، فهم التغيير باعتباره إيديولوجية حتمية، وليس ديناميكيات تشمل المتضررين أو من يشعرون أنهم كذلك.
كاتب سوري
القدس العربي
—————————
تونس .. قفزة في الفراغ/ محمد أحمد بنّيس
لم يُجانب الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الصواب، حين قال، في تعليقه على الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيّد: ”إنّ هناك قراراً إقليمياً، وربما هو دولي، بتصفية الربيع العربي”. والواقع أنّه يصعب فصل ما جرى في تونس، يوم الأحد الماضي، عما شهدته المنطقة منذ الانقلاب الذي قاده العسكر في مصر قبل ثماني سنوات. وعلى الرغم من أنّ ما حدث في تونس يبقى وثيق الصلة بالانحباس السياسي الذي تشهده منذ مدة، لا يمكن القفز على دور القوى الإقليمية، المعنية بتجفيف منابع الربيع العربي، في إنضاج الحدث التونسي، إذ لم يدّخر التحالف الإماراتي – السعودي – المصري جهداً، على مدار سنوات، لإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية، باعتبارها منبع ”عدوى الديمقراطية” التي أصابت المنطقة، ودفعت شعوبها إلى الخروج إلى الشارع والمطالبةِ بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
لا يعني ذلك، بالطبع، استبعاد العوامل الداخلية في تفسير هذا الحدث، لا سيما في ما يتعلق بإخفاق الطبقة السياسية التونسية في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الذي طبع التجربة في بدايتها، وفشلِ حركة النهضة في إعادة تركيب بنيتها وتحديث خطابها، وغيابِ برامج مستعجلة وعملية للحدّ من الاحتقان الاجتماعي. تُضاف إلى ذلك الثقافة السياسية التقليدية التي تنهل منها مختلف مكونات هذه الطبقة، والتي تقوم على الغلبة والثأر والمكايدة الإيديولوجية. هذا على الرغم من أهمية الطبقة الوسطى والحسِّ المدني المتقدّم، نسبيا، لدى فئات واسعة داخل المجتمع التونسي وقوة المجتمع المدني. وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يشكل الذود عن التجربة الديمقراطية محطَّ إجماع بين التونسيين، تحولت هذه التجربة إلى مصدر رئيسٍ لتغذية الانقسام السياسي والاجتماعي. ولا شك أن تعطيل كتلة الحزب الدستوري الحر جلسات البرلمان، وعدم تنصيب المحكمة الدستورية، والنزعة السلطوية والشعبوية التي ما فتئ يُبديها الرئيس الحالي، وتعمّده تسفيه العمل الحكومي النيابي والحياة الديمقراطية أمام الرأي العام، ذلك كله أوجد انطباعا لدى التونسيين بلا جدوى الديمقراطية التي عجزت، في نظرهم، عن تحسين ظروفهم المعيشية. ويمكن القول إنّ الاحتقان الاجتماعي والسياسي وصل إلى حدٍّ لم يعد في وسع المنظومة السياسية التي أفرزتها الثورة تحمله، خصوصا أمام الاستقطاب الحزبي والإيديولوجي غير المسبوق. ولعل هذه كانت الثغرة التي رأى فيها قيس سعيّد فرصة لتقويض الحكم الديمقراطي، واستبدال الشرعية الدستورية بشرعيةٍ شعبويةٍ مشبوهةٍ تفتقد سندها الدستوري والسياسي، فيما يشبه قفزةً في الفراغ.
حدث الانقلاب وأصبح واقعاً، فماذا سيكون مآله في ظلّ المواقف التي عبرت عنها القوى السياسية التونسية والدولية؟ يبقى الجيش التونسي الحلقة المفصلية في ما سيؤول إليه الوضع خلال الأيام المقبلة. صحيحٌ أنّه لم يُبدِ، إلى غاية كتابة هذه السطور، أيّ موقف رسمي، إزاء ما حدث، لكن من المرجّح أنّه لا يرى مانعاً في ما اتخذه الرئيس من تدابير وقرارات. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة وقوفٍ في منتصف الطريق، بمعنى أنّ الجيش لا يريد تبديد الرصيد الرمزي، الذي حازه بعد ثورة 2011، في مغامرةٍ غير محسوبةٍ من رئيس تعوزه الخبرة وبعد النظر، لكنّه في الوقت نفسه غير مستعدّ للذهاب مع هذا الرئيس إلى حد تغيير المنظومة الحالية بأخرى قد تكون مكلفة، وبالتالي يفضل، في ما يبدو، مراقبة الوضع في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة. ولعلّ ما يرجح ذلك موقف الاتحاد التونسي للشغل الذي أكد ”حرصه على ضرورة التمسّك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتّخذ لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي” وهو موقفٌ، علاوة على أنّه يبدو أقرب إلى خيار التمسّك بخيار الديمقراطية، ينبغي النظر إليه في ظلّ الوزن التاريخي والسياسي والاعتباري للاتحاد.
تواجه التجربة الديمقراطية في تونس اختباراً عسيراً ومفصلياً، ذلك أنّ فشل الانقلاب سيعني الكثير لكلّ من يؤمن بإمكانية تطبيع دول المنطقة وشعوبها مع الديمقراطية. أما نجاحه، فسيعني الكثير، أيضاً، بالنسبة لمنطقةٍ يُراد لها أن تبقى أسيرة الاستبداد والفساد والتبعية.
العربي الجديد
——————————
أسئلة تونس مُرَّةٌ .. وإجاباتها أيضاً/ ممدوح الشيخ
لم ننجح وسيفشلون… تكاد هذه الكلمات الثلاث تصبح تلخيصًا أمينًا لواقع المواجهات الممتدة بين ثورات الربيع العربي والثورات المضادة. والسائرون تحت راية الثورة في كل الساحات العربية، بلا استثناء، لا يمكنهم التنكر لحقيقة أنهم لم ينحجوا. والفرق الرئيس بين “مشجّع الكرة” و”لاعب الكرة” أن الأول يستطيع أن يصف لك، وهو متكئ على أريكة، كيف إحراز هدفٍ في شياك الخصم، أما الثاني فيستطيع أن يفعل ذلك بنفسه “تحت ضغظ الخصم”. وأحسب أن من الإنصاف الإقرار بأن ثورات الربيع العربي غلب عليها “حماس المشجّعين”، وغابت عنها، إلى حد كبير، “كفاءة المحترفين”.
وكل العوامل المعيقة للثورات داخليًا وخارجيًا كانت جزءًا من المشهد الثوري في ثورات العصر الحديث كلها تقريبًا، وإن اختلفت التفاصيل. والاكتفاء بالإلحاح عليها، تفسيرا وحيدا، وعلاجا نفسيا في الوقت نفسه، أوجد حالة من الحساسية المبالغ فيها إزاء كل نقد وكل تقويم وكل تقييم. ومع الإخفاق في الوصول إلى الأهداف، انطلاقًا من المعطيات المتاحة (أيًا كانت نواقصها) أصبح مشهد الربيع العربي أقرب إلى مشهد فريق كرة قدم لا يستطيع اللعب “تحت ضغط الخصم”!.
واعتماد حسابات الربح والخسارة على ثنائية إسلاميين/ علمانيين هي جرعة أخرى من قارورة المرارة التونسية التي سبقتها قوارير أخرى، في مصر واليمن وسورية وليبيا والسودان، فالتقييم الصريح لقدرات أغلبية النخب السياسية العربية، بعد اختباراتٍ متتالية، يبعث على الأسى، فيما يتصل بالأفكار والاسترتيجيات والتكتيكات والخطابات. والمثقفون القادرون على المساهمة في إنقاذ السفينة من الغرق، بالإضافة إلى قلة عددهم، كانوا، في معظم الحالات، مبعدين عن مواقع التأثير قبل “الربيع العربي” وبعده. وللأسف الشديد، لم تفلح أيٌّ من التجارب سالفة الذكر في وضع هذه النخبة في موضهعا الصحيح. وفي الحالة التونسية، تشابهت على “تحالف الكرامة” (الحاكم؟) الفروق الدقيقة بين التقاليد والقيم والمصالح العليا. وفي الوقت القاتل، عجزوا عن التمييز بين الاستحقاقات المتعدّدة للمرحلة التي تمر بها البلاد، فـ “الاستحقاق الدستوري” لا يمكنه سدّ فجوة القصور الكبير في “الاستحقاق السياسي”، وكلاهما لم يشكّلا رصيدًا لـ “الاستحقاق الوطني العام”، وكان الإنهاك المخطّط للحكومة استنزافًا مـُخـطَّطًا للشرعيتين: الثورة والدستورية.
والإجابة التي اعتمدها الرئيس التونسي، قيس سعيد، كانت أكثر بؤسًا ومرارةً من السؤال، فالشرعية الدستورية، في القيم والإجراءات معًا، تبقى ثروة وطنية للتونسيين جميعًا، وعليه، فلا يحق له تبديدها، ومؤسسات الدولة التي تمثل المشترك العام المادي والمعنوي التونسي (وبخاصة في المشهد التونسي الراهن: البرلمان، الجيش، والنيابة العامة) كان على الرئيس توقيرها، وتعزيز ما تمثله من رمزية تعلو على كل الاستقطابات السياسية والأيديولوجية، وما حدث أنه قرّر أن يجعلها أول ما يأكله الحريق!!
والإصرار، من الجانبين، على الاستخدام الخاطئ للوسائل يضع تونس كلها أمام اختبارٍ عسير، فالبرلمان المنتخب، أيًا كانت توجهات أغلبيته، يظل الرمز الأكثر استحقاقًا للاحترام لإرادة الشعب التونسي، والحكومة التي استمدّت مشروعيتها منه لا يملك أحد إطاحتها بخطاب شعبوي فيه من الجزافية أكثر بكثير مما فيه من الموضوعية. يضاف إلى ما سبق أن الاستدعاء المكشوف لخطر العنف، اختلاقًا أو تضخيمًا، يحمل في طياته مخاطر كثيرة. أحد أكبر هذه المخاطر أن يكون هناك من يلتقط الخيط داخل الأجهزة الأمنية، فيبدأ في عمل منظم يسفر، في النهاية، عن إعادة بعث الدولة البوليسية في تونس وتضخيمها، ولا شيء يخدم مثل هذه المساعي أكثر من الاستخدام المجاني لخطر العنف المسلح.
الاعتراف بأن نخب الربيع العربي تتحمّل جانبًا من المسؤولية عن الإجهاض المتتابع لثوراته، إجابة مرّة عن سؤال لا يقل مرارة، والاعتراف ضرورة للفهم والعلاج. والتغيير في كل الثورات في التاريخ لا يتم بشكل “معملي”، فهناك دائمًا متضرّرون من الثورة، أو متآمرون عليها في الداخل أو الخارج، أو في الداخل والخارج معًا. ولا أحسب أن ثورة يمكن أن تنتصر ومن يمسكون دفتها يأملون أن يفوزوا بمباراةٍ يشاهدونها من مقاعد المتفرّجين.
العربي الجديد
—————————-
انقلاب قيس سعيّد في غياب المحكمة الدستورية/ أحمد جبر
عندما حقق الرئيس التونسي قيس سعيّد زلزالاً انتخابياً بفوزه الساحق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ضد منافسه نبيل القروي، تشكلت بارقة أمل لتونسيين عديدين شعروا بالانتصار على الأحزاب السياسية المسيطرة من جهة، وعلى سيطرة الأموال المتمثلة بالقروي من جهة ثانية. إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلا، حيث اعترضت عقبات سياسية عديدة ولاية الرئيس الجديد، لم يستطع تذليلها بل زاد من حجمها وأثرها بهفواتٍ وانتكاساتٍ وقراراتٍ لم تتسم بالحكمة السياسية، فقد كانت البداية في اليوم الذي تقدمت مجموعة من الكتل البرلمانية بلائحة لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، حيث أعلن سعيّد أن الأخير تقدم باستقالته إليه، مستبقاً خطوةَ سحب الثقة عن طريق البرلمان بإعلانه قبول الاستقالة، ما أعاد إليه، دستورياً، أولوية تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، حارماً الكتلة البرلمانية الأكبر من ذلك.
من ثم جاء تكليف هشام المشيشي، لتستمر حكومته مع المشكلات نفسها المرتبطة بالتفسير والتأويل الدستوري لطريقة التكليف وحدود الصلاحيات ومرجعية النظر بين البرلمان ورئاسة الدولة. مشكلات دستورية يؤولها كل ضلع من أضلاع مثلث السلطات، بما يتناسب مع مصلحته وتوجهه، من دون إمكانية حسم التأويل لمصلحة أحد، بغياب الناظم لهذه الخلافات (المحكمة الدستورية العليا). وحصل تكليف المشيشي من دون تشاور مع الأحزاب السياسية، ما صدّر المشيشي رجل الرئيس وحكومته حكومة الرئيس. إلا أنه وفقاً للدستور، لا يمكن لأي حكومة ممارسة مهامها من دون نيل ثقة البرلمان، ما دفع المشيشي إلى التنسيق مع الأغلبية البرلمانية لتمرير حكومته، مقدّماً تنازلات لصالح حلفائه الجدد في البرلمان، تتعلق بإعادة هيكلة الحكومة. ووفّر هذا التحالف الجديد له مجالاً للمناورة السياسية. وفي المقابل، سرع في توتير علاقته مع الرئيس سعيّد والأحزاب التي تقف إلى جانب الرئيس، في غياب التوافق بين الأخير وأغلبية النواب. وبدأ تعطيل عمل حكومة المشيشي برفض سعيّد مثول أعضائها أمامه لتأدية اليمين الدستورية، حارماً إياها من إجراء شكلي غير جوهري كما هو الحال بمنح الثقة البرلمانية، رفضٌ رأى به نوابٌ وفقهاء قانون كثيرون أنه ليس من حق الرئيس دستورياً، إلا أن الرئيس سعيّد برّر موقفه أن الدستور يمنحه حق الامتناع عن قبول أداء اليمين من وزراء يتهمهم بالفساد.
خلاف آخر بشان تأويل الدستور لا يمكن البتّ به في غياب المحكمة الدستورية العليا. وقد رفض الرئيس سعيّد تقديم أسماء الوزراء الذين يتهمهم بالفساد، على الرغم من طلب المشيشي المتكرّر، فتسميتهم قد تضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، إذا حكم القضاء بعدم صحة التهم الموجهة إليهم. هذا ما جعل رئيس الحكومة عاجزاً عن إقالة أيٍّ من وزرائه لهذا السبب، من دون تسلم أسماء من وصفهم سعيد بالفاسدين، فما ضمان أن الرئيس لا يقصد غيرهم.
انسداد أفق الحل السياسي في تونس والتأويلات المختلفة والمتناقضة للدستور، وعدم قدرة “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” على البتّ بنزاعات الصلاحيات بين السلطات، لاقتصار عملها وصلاحياتها على الرقابة الدستورية لمشاريع القوانين فقط، أعاد هذا الانسداد إلى الواجهة ضرورة الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية العليا. وفي محاولةٍ غير جدّية من البرلمان، ورفض حثيث من الرئيس سعيّد، فشل مرة أخرى تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ليأتي انقلاب سعيّد غير المسبوق وعقب اجتماع طارئ (عقده في قصر قرطاج) مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرّر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. واعتبر أن خطوته هذه جاءت تلبية لضرورات المصلحة العامة ومتسقةً مع الدستور التونسي، وتحديداً مع المادة 80. ولذلك لم يعلن الرئيس سعيد حل البرلمان وإنما تجميد اختصاصاته، حيث لا يمنح الدستور الرئيس الحق بحل البرلمان إلا في حالة واحدة تكون مرتبطة بعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وهي وضعية غير متوفرة حالياً لحصول حكومة المشيشي على هذه الثقة. إلا أن استناد الرئيس سعيّد إلى المادة 80 من الدستور التي تعطيه الحق باتخاذ التدابير الاستثنائية، في حال افترضنا أن تونس تتعرّض لخطر داهم لا يمكن معه السير الطبيعي لمؤسسات الدولة؛ تمنعه من تجميد اختصاصات البرلمان، حيث تفرض المادة المذكورة أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم. وبالنسبة لإقالة المشيشي، لا يعطي الدستور رئيس الجمهورية الحق بإقالة رئيس الحكومة، وإنما اكتفى بإعطاء الحق له بالطلب من البرلمان التصويت على الثقة الممنوحة للحكومة، ومرتين على الأكثر خلال ولايته لرئاسة الجمهورية (مادة 99 من الدستور التونسي). كما أنه، وبحسب الدستور، لا تعتبر الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، وإنما أمام البرلمان (مادة 95). كما أن رئيس الحكومة المزمع تسميته بدلاً من المشيشي لا يمكنه ممارسة مهامه ومهام حكومته دستورياً إلا بعد منح الثقة البرلمانية، وهذا شرط يبدو بعيد المنال، بعدما أغلقت المؤسسة العسكرية أبواب البرلمان في وجوه النواب.
ومخالفة سعيّد الدستورية الثالثة كانت بتعيين نفسه في منصب النائب العام الجمهوري. صحيحٌ أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تسمية القضاة، وعلى فرض أن الرئيس سعيد قرّر تحقيق سابقة قضائية بتسمية نفسه، إلا أن هذا الأمر لا يتم إلا بناءً على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء (مادة 106 من الدستور)، وهذا ما لم يتوفر بقرار الرئيس سعيد. والمخالفة الدستورية الرابعة والأهم أنه في غياب المحكمة الدستورية العليا لا يمكن تفعيل المادة 80 من الدستور، وذلك لغياب شرط شكلي يتمثل بإعلام رئيس المحكمة الدستورية العليا. وشرط جوهري، حيث حصر الدستور صلاحية إيقاف التدابير الاستثنائية أو تمديدها فقط بالمحكمة الدستورية العليا التي حرص سعيّد على عدم تشكيلها.
صحيحٌ أن في وسع أي قانوني ملاحظة المخالفات الدستورية في القرارات المتّخذة من الرئيس سعيّد بناءً على تفعيل المادة 80 من الدستور، إلا أن الهيئة الوحيدة المخوّلة في البتّ بدستورية أي قرار أو قانون قائم أو مشروع قانون أو نزاع السلطات هي المحكمة الدستورية العليا، المعطل تشكيلها منذ أقر تشكيلها وحدد هيكلتها ومهامها وصلاحياتها دستور عام 2014، (مواد 118 – 124)، محكمة لم يكتب لها أن ترى النور بسبب عدم قدرة البرلمان على انتخاب سوى عضو واحد من أصل الأعضاء الأربعة الذين عليه انتخابهم. فلو أنه كان قد جرى تشكيل المحكمة الدستورية العليا لما وصلت تونس إلى انسداد بأفق الحل السياسي، فالصراع السياسي والتجاذب والتحالفات والانقلاب على التحالفات حالة شائعة في النظم الديمقراطية البرلمانية، إلا أن غياب المحكمة الدستورية العليا في تونس سمح لكل طرف من أطراف الصراع السياسي بتأويل نصوص الدستور لمصلحته، والأخذ بجزء من النص وإهمال أجزاء أو نصوص أخرى.
لم يتوقف الرئيس سعيّد عن تهديد خصومه السياسيين بالقوى العسكرية والأمنية، وفي نهاية المطاف، طبق تهديده ليفتح الباب على مصراعيه لهذه المؤسسة التدخل في الشؤون السياسية والمدنية، تدخّل لن يكون في وسع سعيّد نفسه لجمه مستقبلا، وفي أحسن الأحوال، سيرضى على نفسه أن يتحوّل إلى دميةٍ بيد المؤسسة العسكرية.
كل هذه الحيثيات تجعل من التهم الانقلابية محقّة بحق سعيّد، وإن نفيه لها لا يمكن أن يكون من خلال تصريحات شعبوية جوفاء، وإنما بأفعال جدّية تبدأ بالتراجع الفوري عن الانقلاب الأخير، والدعوة إلى مؤتمر أو حوار وطني شامل يؤسّس لمنع تدخل الجيش بالحياة المدنية وبقائه على الحياد، مؤتمر يضمن تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي تكون قراراتها ملزمةً لكل أطراف الصراع في تونس.
العربي الجديد
———————————
تونس ولبنان:ما بين الرئيسين والشعبين من شَبه/ ساطع نور الدين
بين لبنان وتونس، الدولتين والشعبين، ودٌ وقربٌ وشَبه..يغذيه الزعم بل الوهم المشترك بأن إنتماءهما الى الفضاء العربي منّةٌ وفضلٌ، يبررهما الإيمان الذي ليس له سند، بأن البلدين أرقى من أشقائهما، لا سيما الجيران منهم، وأكثر ثقافة وعلماً، وإندماجاً بالحضارة الغربية وقيمها وتقاليدها.
لكن تونس قررت فجأة الافتراق عن لبنان والمضي في طريق سريع شقته لنفسها، منذ أن تفتحت في حدائقها وردة الربيع العربي الاولى، إثر الإطاحة بالدكتاتورية بطريقة سلمية هادئة، وإرساء تجربة ديموقراطية عربية رائدة، بدستورها ومؤسساتها وأحزابها. عندها تخلت تونس عن هواية التوأمة مع لبنان، لكنها ظلت تحتفظ ببعض من أوجه الشبه، التي ظهرت في الايام القليلة الماضية على نحو فاقع، ومسيء للاشقاء التوانسة جميعاً.
مساء الاحد الماضي، عندما إستولى الرئيس التونسي قيس سعيّد فجأة على الحكم، وصادر صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فوجىء لبنانيون كثيرون، لم تكن أحوالهم المعيشية تسمح لهم بمتابعة مقدمات ذلك الحدث التونسي، المعروفة منذ أشهر خلت، بأن النظام السياسي، الديموقراطي، في تونس إنهار، أو هو على الأقل لم يعد يعمل بشكل صحيح..ما يعني أن الأشقاء التوانسة تراجعوا سنوات الى الوراء، عن تجربتهم الاستثنائية الفريدة، التي كانت آخر ما تبقى من الذكريات المحببة للربيع العربي.
من دون سابق معرفة، تراءى الرئيس التونسي في صورة الرئيس اللبناني ميشال عون، على ما في شخصيتيهما من فوارق وتناقضات. الشعبوية وحدها كانت كافية للدخول في مثل هذه المقارنة الجذابة بين الرجلين، عدا عن كونهما على عداء قديم ومستحكم مع السياسة، بأبسط قواعدها وأعرافها. الانقلاب على الدستور، حصل بالفعل في تونس، لكن لبنان ليس بعيداً عن هذا الانقلاب. ولم يعد هناك شك في أن سعيّد وعون يمارسان السلطة بأسلوب فردي عشوائي، ويستخدمان صلاحياتهما الرئاسية لإصدار قرارات رئاسية مدوية، قبل أن يفكرا في النتائج والعواقب والمخاطر. وما يتردد اليوم في تونس عن أن رئيسها لا يعرف ما هي الخطوة التالية لمصادرته السلطة، شائع أيضاً في لبنان مع كل قرار يتخذه عون.
ولا تقتصر المحنة التونسية_اللبنانية المشتركة، على الجهل بما يدور في ذهن الرئيسين أو في أروقة القصرين بين مستشارين ليس عندهم أذهان حكيمة.. بل هي تمتد الى الوسط السياسي، الذي تقوده رموز وأحزاب يسهل الطعن بشرعيتها ونزاهتها ويسهل الشك في حسها الديموقراطي، بدليل تحويلها السلطتين التشريعية والتنفيذية الى سيرك مفتوح ، لا علاقة له بالسياسة ولا بالهموم المعيشية والاقتصادية والصحية للشعبين، بل هو مجرد شاهد على ألاعيب سياسية تعبر عن ضيق الافق وتردي الوعي.
يتصدر الرئيسان المشهد اليوم، فقط، بدعوى مكافحة الفساد السياسي والمالي، بغض النظر عما إذا كان هذا الادعاء يكفي لتصنيفهما مع الصالحين والجديرين بالحكم. نقاش الاهلية فات أوانه، لا سيما وأن للرئيسين جمهوراً واسعاً، يشجعهما ويتقاسم معهما القيم والافكار والشعارات الشعبوية نفسها، ويمنحهما شرعية خاصة لا صلة لها بالدستور ولا بالعملية السياسية ولا بالديموقراطية.
على هامش تلك المقارنة بين البلدين، يقف الجيش التونسي واللبناني، على الحياد، حتى الآن على الاقل، وهو ما يشكل ضمانة أكيدة بفرص العودة الى صناديق الاقتراع وبقية أحكام وقواعد اللعبة الديموقراطية، من دون الاستعانة بالعسكر وطائراته ودباباته.. ومن دون اثارة نزاع أهلي، يمكن للبنان أن يستعيد من خلاله أمجاده الدموية الماضية.
أما في جوهر هذا المشهد الثنائي، فإن ظهور جمهور تونسي ولبناني شعبوي، ولو على مسافة مختلفة من الرئيسين، نتيجة مظاهر الخلل الصادمة في أداء النظامين السياسيين، هو واحد من الدروس الاصعب للتجربة التونسية المضطربة، وواحد من الخلاصات الأسوأ للتجربة اللبنانية المتعثرة. لن ينتظم هذا الجمهور لا في تونس ولا في لبنان، في أحزاب وحركات وتيارات، بل الارجح سينحدر بعد فترة وجيزة الى ظاهرة فوضوية، تردد شعار “كلن يعني كلن”، بلا أي معنى.
المدن،
——————————
تونس الضرورية/ حازم الأمين
تسعى تونس لتجاوز صدمة قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وهي خطوات أثارت مخاوف أن تكون بلاد الياسمين أمام السيناريو المصري.
مؤيدو القرارات تحفظوا على احتمالات ما تنطوي عليه من احتمالات السقوط في الحكم الفردي أو العسكري، والمعترضون عليها عادوا عن دعوات المواجهة وما تنطوي عليه هذه المواجهة من مخاطر في الشارع.
ونحن بدورنا أصابنا الخوف على تونس، وعلى تجربتها، ونملك من الأسباب التونسية وغير التونسية ما يبرر خوفنا، وهنا عرض لبعض مبررات هذا الخوف.
لطالما أجابنا أصدقاؤنا في تونس حين نغبطهم على نجاتهم من مآلات الربيع العربي، بأن الصعوبات التي يواجهها بلدهم هائلة، وأن تجربة ما بعد الثورة ثقيلة ومرهقة وخطيرة أحياناً. والحال أن سؤال الغبطة وجوابهم عليه صادر عن حساسيتين مختلفتين تماماً، فحساسية الغبطة صادرة من تجارب الفشل غير التونسي، وصادرة أيضاً عن محرومين من نعم الحرية والمساءلة والانتخاب، فيما حساسية الإحباط التونسي تعود لبيئة تتسع لتقييم التجربة ولنقدها بقسوة.
زرت تونس نحو 10 مرات بعد ثورتها. وأنا متمسك بغبط التونسيين على الموقع الذي نقلتهم إليه ثورتهم. التجربة صعبة ومعقدة طبعاً ويتخللها الكثير من الخيبات، لكن الفارق الذي صنعته الثورة بيننا نحن بؤساء العالم العربي، وبينهم، هم أحراره، كبير فعلاً.
أَصِل إلى تونس كصحفي، وفي سياق حدث أو قصة أو فيلم. لا قيود إطلاقاً على عملي الذي يلامس أحياناً حدود إدانة النظام فيها بالتورط بالإرهاب. أعمل على قصتي الصحفية التي تبدأ من سجون قسد في سورية، وتمر ببيوت الضيافة “المجاهدين” في تركيا، وتنتهي بمنازل عائلات الجهاديين في مدينة بنزرت في تونس.
الحلقة التونسية في قصتي هي الحلقة الأكثر تخففاً من القيود. في سجون قصد في شمال سوريا تتيح لنا الـ”أساييش” إجراء مقابلة مع أسرى من “داعش” لكن تحت رقابتها، وضمن برنامج زيارة بإشرافها، وفي تركيا نزور مضافات “الجهاديين” سراً محاولين مراوغة الشرطة والأمن. في تونس تنعقد قصتنا على وقائع خارج أعين السلطة. وقائع تدين أطرافاً في النظام التونسي بتسهيل ذهاب الجهاديين إلى سوريا والعراق. يجري ذلك من دون أن نشعر بثقل الأمن وبخطر استهدافنا.
صحيح أن “تونس النهضة” هي أكثر من أرسل إلى “داعش” مقاتلين، لكن “تونس الثورة” هي أكثر من أتاح لنا تقصي حكاياتهم. ومن المرات النادرة التي يشعر فيها الصحفي العربي أنه يملك زمام قصته، وأن لا شريك له فيها سوى حريته، هي عندما يكون في تونس.
هذا ليس تفصيلاً أيها التونسيون، وبالنسبة لنا نحن العرب، غير التونسيين، هذا ليس “حقاً بديهياً”. هذا أمر يستحق أن تخافوا عليه. لكنه لا يتوقف عند حقيقة شعور صحفي بحريته في بلدكم. فالصعوبات الهائلة والفساد الكبير الذي تشهروه في وجهنا لكي لا نبالغ بغبطكم على التجربة، هو جزء من نزاع بينكم وبين نظام ما بعد الثورة، ولهذا النزاع تصريف في الانتخابات وفي الصحافة وفي توجهات الرأي العام.
وهذا التصريف أفضى في مرات كثيرة إلى هزيمة انتخابية لحركة النهضة الإسلامية، وأفضى إلى انفكاكها، وإن على نحو مراوغ، عن الإخوان المسلمين، وأفضى إلى وصول الراحل الباجي قايد السبسي إلى الرئاسة رغماً عنها. ويصح ذلك في وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج، وها هو اليوم يخوض مواجهاته مع النهضة أيضاً، التي انزلق خلالها إلى موقع شعبوي نتمنى أن تكون قد ضبطته آليات الثورة، والحساسية التي أنتجتها في مواجهة حكم الأفراد.
الفساد وفشل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا جزء من نقاش عام يمكن منازعة السلطة عليه، بينما الفساد في بلادنا وهو يوازي ويفوق الفساد في بلدكم، غير مطروح للنقاش العام. هو جزء من آليات علينا قبولها بصمت. الانقسام المذهبي في لبنان يحول الفساد إلى حصص “شرعية” لأمراء الطوائف. والفساد في سوريا هو أهون موبقات النظام هناك. وفي مصر هو حق طبيعي للجيش. وفي الأردن تتقدم مصلحة العرش مصالح الناس في مكافحة الفساد. الفساد في بلدكم جزء من نقاش أتاحته الثورة، ولطالما أتاحت الانتخابات فرص المحاسبة، وأكبر دليل على ذلك مؤشر تراجع حصة حركة النهضة في البرلمان.
لكن ثمة مؤشر آخر يستدعي الحرص على التجربة التونسية، وهو مؤشر غير تونسي. فليس تفصيلاً لنا نحن العرب غير التونسيين أن يكون في حوزتنا شيء اسمه “الاستثناء التونسي”. شيء نجيب به على من يرى استحالة انسجامنا مع تجارب أنظمة الحرية والمحاسبة والانتخاب. ومن جهة أخرى تستحق التجربة التونسية احتضاناً من الحريصين في العالم على وجود نموذج عربي يتولى تزخيم القناعة بنجاعة القيم التي قامت عليها الثورة في تونس.
الحرة
——————————–
“الانقلاب”.. للأسف.. بين مصر وتونس/ حسن منيمنة
يرفض الرئيس التونسي قيس سعيّد وصف خطواته بالانقلاب. كيف يجوز الحديث عن انقلاب فيما خطواته تندرج في إطار صلاحياته الدستورية؟
الرئيس سعيّد يقول إن نص الدستور يمنحه هذه الصلاحيات لتجنيب البلاد الخطر الداهم. أليست الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس خطراً متحققاً، أي ما يتجاوز توصيف الخطر الداهم؟ ثم أن الدستور يطلب منه استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. هو أوفى هذا الشرط حقّه بإبلاغهما، أو على الأقل بمكالمة رئيس مجلس النواب، وإن لم يدرك هذا الأخير أن حديث رئيس الجمهورية عن الطوارئ يتجاوز التجديد الاعتيادي للحالة التي سبق إعلانها. ثم أن المادة 80، التي اعتمد عليها قيس سعيّد، تفترض أن مجلس النواب سوف يبقى معها في حالة انعقاد دائم. وهو كذلك، وفق ما يؤكد عليه قيس سعيّد.
الرئيس لم يحلّ المجلس، بل مارس صلاحيته، المستقاة من مادة أخرى، بتجميده. أي أن مجلس النواب يمكن أن يبقى بحالة نظرية من “الانعقاد الدائم”، كما هو مثلاً حال مجلس الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي، عند الحوادث الجسام، دون أن يعني ذلك أن أعضاء هذه المجالس هم بالفعل في مباني مجالسهم في نشاط مستمر.
بنبرة رئاسية مرتفعة، أمام حضور صامت من بعض المدعوين الذين جالسوه بما يشبه التلامذة في الصف الدراسي، ومع التذكير بشهاداته العلمية، أكد قيس سعيّد أن من يصف خطوته بالانقلاب لا يفقه القانون، وأن عليه العودة إلى الدراسة.
عفواً يا فخامة الرئيس، لا حاجة للعودة إلى مقاعد التحصيل. ما حدث في تونس انقلاب، كما كانت إطاحة عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي انقلاباً.
من العبث محاولات التملّص من خلال التجميل، والحديث عن إرادة شعبية دفعت الجيش إلى التحرك في مصر، أو الكلام التبريري الشكلي عن صلاحية دستورية يمنحها الدستور لموقع الرئاسة الأولى في تونس. هنا وهنالك، النتيجة هي إنهاء العمل بالسلطة المنتخبة، وحصر السلطات الثلاث بيد من أقدم على الانقلاب، وإن تسلّح، كما يفعل قيس سعيّد، بتأويلات شاطحة لا سبيل لردعه عنها، لغياب مرجعية المحكمة الدستورية.
الانقلاب بحدّ ذاته ليس بالضرورة شرّاً مطلقاً. وفي الحالة المصرية يمكن استشفاف دوافع الانقلاب في التدليس الذي أوصل محمد مرسي والإخوان المسلمين إلى الحكم. وصول مرسي إلى سدة الرئاسة كان نتيجة انتخابات حصلت في مرحلة انتقالية بعد ثورة أطاحت بالسلطوية ولم تكن قد بنت بعد أسس النظام الجديد. وما كان فوزه بالرئاسة ليكون لولا اجتماع قوى الثورة على الدعوة للتصويت لصالحه، ليس تأييداً له ولكن لضمان عدم عودة النظام الساقط بحلّة جديدة، وذلك على أساس توافق يتأرجح بين الضمني والصريح على السعي إلى تأسيس الدولة التي تجسّد الإرادة الشعبية. وإذ بمحمد مرسي، والإخوان من ورائه وأمامه، يتصرّفون وكأن الانتخابات قد منحتهم التفويض العام لإعادة صياغة الدولة والمجتمع وفق توجهاتهم العقائدية، الخارجة عن إجماع المصريين وتوقعاتهم.
أي أنه، في الحالة المصرية، وبغضّ النظر عن طريقة الإخراج، جاء انقلاب السيسي ليدحض انقلاب الإخوان على الثورة. والحصيلة الجلية، مع المسافة الزمنية التي تسمح بتبيّنها، أن الثورة كانت قد فشلت ساعة سعى الإخوان إلى تجييرها لجماعتهم وعقيدتهم، رغم أنها تحققت ابتداءً بما يتعداهم.
الانقلاب على إرادة الناخبين مدان بالتأكيد، لكنه في الحالة المصرية جاء بعد أن ظهر للملأ أن الفائز بالانتخابات ذاهب إلى المخادعة، بما يتعدى دوره المحدود المتوقع في المرحلة الانتقالية، ويؤسس لسلطوية جديدة، وأن الانتظار إلى الانتخابات التالية مجازفة، في خضم سعي الإخوان، الذي أمسى شبه معلن بعد الفوز، إلى تفكيك النظم وإعادة تركيبها، بما يأخذ مصر إلى مكان وأحوال لا تعبّر بتاتاً عن رغبات المصريين. الترياق المرّ الذي ارتضى به المصريون للخلاص من السلطوية الإخوانية كان العودة إلى سلطوية عسكرية.
محمد مرسي أخطأ، وكان عليه الإصغاء إلى أصوات الأصدقاء والخصوم على حد سواء، التي دعته وجماعته إلى التراجع عن مسعى تحويل مصر إلى ما لا توافق بشأنه، وربما أن الإخوان المسلمين في مصر كانوا عاجزين، من فرط نشوة العائدة إلى وهم اقتراب المراد، عن الشروع بالمراجعات. دون أن ينفي ذلك الظلم الذي طال مرسي والعديد من الإخوان، وجموع الناشطين، في ظل حكم السيسي.
انقلاب تونس لا يشبه انقلاب مصر بشيء. خلافاً للمبالغات المؤسفة التي لجأ إليها بعض الزملاء في الإعلام العربي، لا حزب “حركة النهضة” هو “الإخوان”، ولا “الإخوان” (ولا النهضة) حكموا تونس على مدى السنين العشر الماضية، ولا هم بالتأكيد يحاولون تجيير انتخابات انتقالية لصالحهم في تجاوز للتفويض والتوقعات، واحتشاد المصريين عام 2013 لرفض سلطوية الإخوان الناشئة لا يمكن أن “يستعار” لتزيين الحراك الشعبي المؤيد للخطوة الانقلابية التونسية، والذي لم يجمع نسبياً إلا الأعداد القليلة.
من حيث الشكل، ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد هو خاتمة قد تدرّج إليها في خطابه وسلوكه على مدى السنين الماضية، إذ بدا في أكثر من مناسبة منزعجاً من أن النظام السياسي في مرحلة ما بعد الثورة لا يمنح الرئاسة الأولى حصرية الحل والربط.
وربما، عند متابعة ما تتشكى منه فخامته، هو أن ما لا يستسيغه أبداً هو هذا التجريح لمقامه السامي من جانب النواب وغيرهم من العوام. في خطوته الأخيرة، وإن جرى تأطيرها في السياق العام، جانب خاص غير خفي. يبدو أن الرئيس، سواء في الجامعة التي سبق أن شغل المناصب فيها، أو في مكتب الرئاسة، يفضّل الحضور الذي يصغي إليه دون مقاطعة أو تحدٍ، وإن كان القدر المرتفع من الفصاحة والبيان في كلامه غير كافٍ لتلطيف الضرر الذي أصاب به قيس سعيّد الواقع السياسي التونسي.
تعاني تونس بالتأكيد من تعقيدات بنيوية سياسية، عائدة إلى افتقاد نظام ما بعد الثورة للنجاعة الكافية في تأطير الحياة السياسية وتفعيلها وتنشيطها وإتاحة المجال لبروز أصوات جديدة، وذلك في خضم واقع اقتصادي مقلق، مع استمرار التحكم الطويل الأمد لجهات نافذة بمفاصل القطاعات الاقتصادية، وتعايشها الضمني مع الواقع السياسي، قديمه وجديده، بما يعترض مساعي الإصلاح الصادقة، بالإضافة إلى وطأة الجائحة والأعباء الإضافية المستجدة نتيجة للأوضاع العالمية الحالية. وهشاشة هذه الأحوال تفتح الباب بدورها لنفوذ جهات خارجية، تأتي إلى تونس مشحونة بخصوماتها، ليكون تحبيذها لطرف سياسي تونسي على آخر مشروط بتوريطه بمواجهة لا تعني تونس ابتداءً.
ليس هذه حال تونس دون غيرها، ولا هو مختلف إلا ببعض الكم وبعض النوع، عمّا شهدته تونس نفسها ودول غيرها من الأحوال في أزمنة أخرى. ما يدعو لبعض الأمل هو قدر من الخصوصية لتونس في ثلاثة أوجه، فرّطت بكل منها خطوات قيس سعيّد الأخيرة، وإن بمقادير مختلفة.
لتونس حركة عمّالية غير مطوّعة سياسياً. قد لا ترتقي مقومات هذه الحركة، معها النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية إلى مستوى “المجتمع العميق”، بما يقابل “الدولة العميقة” في دول أخرى، الذي يشكل الضامن القطعي للمصلحة الوطنية، كما يصفها ويتمنى لها بعض التونسيين الخبراء، ولكنها بالتأكيد تشكل وزناً هاماً يقف عائقاً أمام المغامرات السياسية، وهي بالفعل قد خفّفت من وطأة التأزم السياسي في أكثر من جولة سابقة، ونالت لذلك التقدير العالمي.
على أن التعويل عليها في أن تمنع الانزلاق إلى الاستبداد، الذي سبق لها أن تعايشت معه، ليس في مكانه، لا لمطالبتها بما ليس من اختصاصها وحسب، بل لما يترتب عن ذلك من تجاذبات سياسية في داخلها. وعليه فإن ردة فعل الحركة العمالية على خطوة قيس سعيّد، التي جاءت حذرة وحمّالة أوجه، قد تكون التجاوب العملي في مواجهة أزمة سياسية حادة لا ترتقي، مصلحياً وعمالياً، إلى ما يستدعي حرق الأوراق.
يبدو قيس سعّيد على درجة من الاطمئنان إلى أنه قد ضمن جانب الحركة العمالية، وفي هذا ضرر لها، ولكنه لا يزال عَرَضياً. رئيس الجمهورية ليس قادراً على فرض قراره على الحركة العمالية المستقلة، ولكنه، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أقدم للتوّ على زجّ الجيش التونسي في المجابهة السياسية مع خصومه، ولوّح بالمزيد، وفي هذه الخطوة تفريط بإنجاز هذا الجيش الوطني، على مدى أكثر من عقد، بالنأي بالنفس عن أي تلويث سياسي، وبتوجيه كل طاقاته لمكافحة المخاطر الأمنية التي عاشتها ولا تزال تعيشها تونس. إقحام المؤسسة العسكرية بخطوات بعيدة عن اختصاصها ومسؤولياتها والمهام المولجة بها هو الخطر الداهم، والشواهد من التاريخ أن باب توريط الجيش بالسياسة، حين يفتح، من الصعب إعادة إغلاقه.
على أن التعدي الأكبر على الخصوصية التونسية، من خلال خطوة قيس سعيّد، قد لا يكون جلياً أو صريحاً في كلامه، ولكنه مكشوف وواضح في التوصيف الذي تحظى به هذه الخطوة في الإعلام الخارجي: “سقوط آخر معاقل الإخوان”، “نظام الإخوان في تونس يترنح”.
أن تكون حركة النهضة قد نشأت وفق صيغة إخوانية، ونالت الدعم والتأييد والتعاطف من حركات إخوانية مختلفة في مراحل عدة، بعيدة وقريبة، أمر مفروغ منه. ولكن أن يفترض مطلق التماهي بينها وبين التنظيم العالمي للإخوان، في تصوراته المتفاوتة بين الواقع والخيال، ففي الأمر تجاهل للتجربة الذاتية لهذه الحركة، وللمقتضيات والخيارات التي اعتمدتها في المراحل المختلفة من نشاطها، ولمراجعاتها النظرية والتبديل في سياساتها في مرحلة بعد الثورة. بل في الأمر تفريط بجوانب عدة ذات أهمية تتجاوز الإطار التونسي، ضمن مواقف النهضة وسلوكها، ولا سيما منها ما أقدم عليه راشد الغنوشي فيما يكاد أن يكون المسعى التأصيلي الوحيد، في الفكر الإسلامي المعاصر، للتوفيق بين القيم العالمية والأسس والمنطلقات الدينية.
خصوم الغنوشي التونسيون يعمدون إلى إبراز الأقوال، العلنية والمسرّبة، لتدعيم تصوير يعتبر أن كلام الإصلاح والقيم وما أشبه ما هو إلا نفاق لتمييع الاعتراض على المسعى الإخواني السلفي الجهادي التكفيري، حيث أن نتيجة كل هذه التوجهات التي تزعم الاختلاف في نهاية المطاف واحد، أي إقصاء من لا يندرج مع الرؤية الشمولية الإسلامية من الحياة العامة عند أدنى حد. المعضلة في هذا الموقف، في الحالة التونسية بالتأكيد، أن الزعم، أي افتراض النفاق والعمل السري للاستيلاء على الوطن ومن ثم العالم، لا ينسجم مع شحّة الأدلة المقدّمة لدعمه.
الغنوشي وصحبه يحظون كذلك بقراءة مشابهة من جانب الأوساط الإسلامية المتشددة، من حيث اتهامهم بالتمييع والتدليس والمخادعة. ولكن في حين يرى المتزمتون العلمانيون أن الهدف المخفي هو الاستيلاء على تونس والعالم لصالح الإسلام المسيّس، فإن المتشددين الدينيين يعتبرون أن المقصود تشتيت الأمة وتبديد الهمّة، تمهيداً للعلمنة وهدم بنيان الدين.
بعيداً عن هذه القناعات، ورغم غياب التجانس المطلق، فإن الظاهر، سواء من حيث الإصغاء إلى المنضوين في النهضة أو من حيث استقراء سلوكهم، هو إقرار هذا الحزب، بغضّ النظر عن خلفيته، بأن المجتمع التونسي تعددي، فيه من يعتمد على المرجعية الدينية كأساس مبدئي، أخلاقي وسلوكي ثم سياسي، وفيه من يجنّب الدين الأبعاد السياسية نظرياً وعملياً، وفيه من يتوجه إلى مرجعيات مبدئية أخرى، حقوقية، عالمية، أممية. في هذا الإقرار خصوصية مهمة على مستوى الفكر الإسلامي المعاصر ككل، وليس فقط على المستوى الوطني التونسي.
وبطبيعة الحال، لا يشكل هذا التوجه حالاً أحادية في الأوساط التونسية الملزمة دينياً، بل تظهر كذلك التصورات التأحيدية والنافية للآخر. على أن الواقع الذي يمكن استشفافه أنه، نتيجة للوزن المعنوي لراشد الغنوشي ورفاقه في النهضة، فإن مركز الثقل في الأوساط المتدينة هو القبول بالواقع التعددي.
وفي مقابل رفض هذه الحالة عند بعض الهامش المتدين، ثمة رفض، أكثر حدة وأكثر جهورية، عند هامش علماني يساري في أغلبه معارض لحضور التوجهات الدينية في السياسة.
الفرادة التونسية، أو ما يقترب من الفرادة، هو أن الإقرار بالتعددية، كحالة إيجابية صريحة أو كحالة ملتبسة إنما واقعة ومستحقة للاستمرار درءاً للأسوأ، هو الغالب على المجتمع التونسي ككل، وإن كان ثمة اعتراض من الأطراف. هنا مكمن الرصيد البناء في النموذج التونسي للمحيطين العربي والإسلامي، وليس النجاح أو الفشل في السياسة.
يُشهد لقيس سعيّد أنه لم يوظف التجاذب المشتعل عند الهوامش في خطوته الأخيرة. غير أن ما أقدم عليه يندرج تلقائياً لمصلحة إصرار الهامش السياسي المعارض للتوجهات الدينية في السياسة على تصوير “النهضة”، أي “الإخوان” أي “الإسلام السياسي العالمي”، حيث الفوارق بين النهضة وتنظيم “الدولة الإسلامية” مجرد تفاصيل، على أنها “شر مطلق” وعلى الإمعان برفض أي تسوية أو تعايش أو قبول بوجودها. بالتأكيد، المتشددون الإسلاميون يريدون لمن لا يرضخ لهم الزوال. واقع الحال، أن هذا الموقف ليس بعيداً عن موقف بعض المتشددين العلمانيين الذين ينفون الحقوق السياسية فعلياً عن أصحاب كل طرح لامس الاعتبارات الدينية كمرجعية.
خطوة قيس سعيّد تسرّ المتشددين العلمانيين، حين تطرح على أنها سقوط لحكم “الإخوان”، ولكنها ترضي كذلك المتشددين الدينيين، الذين يرون في مواقف النهضة توفيقا،ً بل تلفيقا، بين شرعية الإسلام ومشروعية النظام العالمي.
انقلاب قيس سعيّد تجاوز للعرف السياسي التونسي الذي تشكل في مرحلة بعد الثورة، ولكنه أيضاً إشعار بأن هذا العرف لم ينتج النظام الناجح الناجع.
هل ينجح قيس سعّد بأن ينتقل بتأطير خطوته هذه إلى صيغة الصدمة التي تدعو جميع شركاء الوطن إلى إعادة النظر بمسار مأزوم؟ هل يتفاعل سعيّد بإيجابية مع دعوات الحوار للخروج من هذا المأزق الجديد؟ ربما أن مقومات الفرادة التونسية من شأنها أن تسمح ببعض الأمل في هذا الصدد.
الحرة
——————————
تونس.. الولادة من الخاصرة/ نضال منصور
خلال كل السنوات العجاف التي تلاحقت بعد انهيار “الربيع العربي” ظلت العيون محدقة تراقب ثورة الياسمين في تونس، وتضرب بها مثلا على التحول الديمقراطي، وتتغنى بقدرة النظام السياسي على تجديد نفسه، والقدرة على اجتراح الحلول في ظل كل التحديات والظروف.
ربما لم يكن الواقع جميلا في تونس كما كنا نتطلع إليه.. كانت تمنيات ورهانات بعد إخفاقات “الربيع العربي”، وما راج وساد بأن الديمقراطية لا تليق بالمجتمعات العربية، وبأنها ليست أكثر من “سلم” لصعود تيارات أو أحزاب مستبدة جديدة لتعيد إنتاج أنظمة مستبدة بأقنعة جديدة مختلفة.
كنت أزور تونس بانتظام، وكنت سعيدا وفخورا بهوامش الديمقراطية التي تحققت، وبالحريات التي انتعشت بعد حقبة طويلة من حكم بوليسيّ، والحقيقة أنني كنت أسمع غضبا لا يمكن إخفاؤه من الناس الذين ازدادوا فقرا، وكنت أشاهد مواجع الناس من وضع اقتصادي يطحنهم، في وقت كانوا يرون “طبقة” سياسية جديدة تغتني وتتمركز بيدها السلطة.
حالة الاستعصاء السياسي كانت تعصف بتونس؛ فالنظام الديمقراطي الذي شُيّد بعد الثورة وبعد سقوط نظام بن علي كان ينتج توازنات سياسية تعطل آليات عمل الدولة، وتفاقمت هذه الأزمة خلال الأشهر الست الماضية بعد الصراع العلني الذي استحكم بين رئيس الجمهورية من جهة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى، وأصبح الوضع خطيرا جدا ولا يُطاق بعد تفشي جائحة كورونا، ووفاة 18 ألف تونسي بهذا الفيروس اللعين، وإعلان الحكومة انهيار المنظومة الصحية، والتزايد الكبير للمديونية.
كانت تونس تحتفي بذكرى عيد الاستقلال، وبمرور أكثر من 10 سنوات على ثورتها حين خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرارات يُحكم فيها سلطته المطلقة، فيجمد عمل مجلس نواب الشعب، ويرفع الحصانة عن أعضائه، ويُقيل رئيس الحكومة.
أعلن رئيس الجمهورية قراراته الموجهة للشعب التونسي بحضور قادة الجيش والأمن في رسالة واضحة إلى أنهم يوافقون ويدعمون قراراته، وعلى الفور كان الجيش والأجهزة الأمنية يمنعون رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، وحين خاطبهم مطالبا إياهم بحماية الدستور، أجابوه بأنهم يحمون الوطن.
منذ تلك اللحظة وتونس والعالم منشغلون بتقييم ما حدث، يتساءلون: “هل ما حدث انقلاب على شرعية الدستور والدولة”؟
الرئيس قيس سعيد يدعي أنه يحتكم إلى الفصل (80) من الدستور الذي يعطيه الصلاحية في “اتخاذ تدابير في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن، وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي بدواليب الدولة”.
والرئيس -الخبير الدستوري- يتجاهل أن النص الدستوري يُحتم عليه استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ويشترط أن يظل مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، لا أن يُصدر فرمانا بتجميده، وبإقالة رئيس الحكومة.
لم يطل صمت الغنوشي، زعيم النهضة الذي حاول دخول البرلمان وظل معتصما محتجا على أبوابه، إذ أعلن أن قرارات رئيس الجمهورية مخالفة للدستور، وانقلاب على مؤسسات الدولة، ودعا الشعب إلى الوقوف ضد مشاريع الانقلاب، ورفض العودة إلى ما أسماه دياجير الحكم الديكتاتوري.
الإعلامي المرموق، رئيس تحرير جريدة الصحافة، زياد الهاني، أول من كتب بشكل جريء على صفحته على الفيسبوك قائلا “عندما تقوم بتجميد برلمان أكد الفصل (80) من الدستور بقاءه في حالة انعقاد دائم، وتغلق بالجيش أبوابه، فهذا اسمه انقلاب، ولا يحتمل تسمية أخرى”.
وتابع كلامه “عندما تقوم بإقالة حكومة وعزل رئيسها الذي لا يمكن لغير البرلمان سحب الثقة منه، فهذا اسمه انقلاب ولا يحتمل تسمية أخرى”.
وختم الهاني كلامه “الذين فرحوا بقرارات قيس سعيد لأنها أراحتهم من حكومة فاشلة، وائتلاف حكم راكم معاناتهم وهمومهم، أكدوا أننا ما زلنا غير مؤهلين للديمقراطية، وغير جديرين بالانتماء للعالم المتحضر، حيث تنتخب الشعوب حكامها عبر صناديق الاقتراع، وتسحب الثقة منهم عبر صناديق الاقتراع عندما يفشلون، لكن هل تعتقدون أن هذا الانقلاب سيحل مشاكل البلاد”؟
رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يستند إلى قاعدة حزبية، جاءت به صناديق الاقتراع، واستطاع أن يهزم قادة الأحزاب السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي التونسي، وفي مقدمتها حزب النهضة، وقلب تونس، وحتى الزعماء السياسيين الذين كانوا يحملون إرث الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ومن بعده الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
إذن الرئيس قيس سعيد ثمرة لصناديق الاقتراع، في انتخابات حظيت بمراقبة العالم وإعجابه، وحين فاز سعيد بشكل كاسح سمع قصائد المديح من النهضة قبل كل الشركاء الحاليين في السلطة بمواقفه، وبالتالي فهو لم يأتِ على ظهر دبابة، ولا يمكن المزايدة عليه أو الطعن بشرعيته.
في كل الأحوال صدى قرارات قيس سعيد لا يزال يخلط الأوراق، وربما يكون أهمها وأبرزها، كيف استطاع رئيس جمهورية أن يُقنع قادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يكونوا إلى صفه، حلفاء له في مغامرة خطيرة؟ وهل أخذ الرئيس قبل استحواذه على السلطة الضوء الأخضر من قادة دول العالم لمساندته، أو السكوت وعدم التدخل، والانتظار حتى يظهر الدخان الأبيض من قصر قرطاج؟
في الداخل التونسي عارضت معظم الأحزاب قرارات رئيس الجمهورية؛ فالنهضة التي تملك الحصة الأكبر في البرلمان وصفته بالانقلاب، وكتلة قلب تونس الثانية بالقوة البرلمانية اعتبرته خرقا للدستور. وكتلة التيار الديمقراطي، وكذا الأمر ائتلاف الكرامة.. رفضاها.
ورغم أهمية الأحزاب في المعادلة السياسية الداخلية بتونس إلا أن الاتحاد العام للشغل يعبر عن الثقل الشعبي، وموقفه أعطى شرعية ومبررا لقرارات رئيس الجمهورية، حين اعتبر أن “الأزمة بلغت أقصاها، ووصلت حد تعطل دواليب الدولة، وتفكك أوصارها وأجهزتها، وأن تردي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتعمّق معاناة الشعب، وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات، وتفشي الفساد، ونهب المال العام، واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طوعا، وبتطويع التشريعات والأجهزة، ومنها القضاء، طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد، ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار”.
وإذ أعطى الاتحاد العام للشغل سياقا لهذه التدابير الاستثنائية فإنه اشترط أن يرافق القرارات التي اتّخذها الرئيس الضمانات الدستورية بضبطها بعيدا عن التوسّع والاجتهاد، والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم، وضمان احترام الحقوق والحريات.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المؤسسة التي صمدت إبان حكم بن علي، ولم تخضع، أكدت بأنها ستبذل جهدها للدفاع عن الحقوق والحريات، واستقلال القضاء، واحترام دولة القانون ضد مخاطر الانزلاق نحو الديكتاتورية، محذرة من أن تجميع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بيد الرئيس يثير جملة من المحاذير، مبينة أن تأويل رئيس الجمهورية للفصل (80) فيه بعض التجاوز، لاسيما ما يتعلق بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
ورأت الرابطة على لسان رئيسها أن سعيد استمد شرعية تلك الإجراءات الاستثنائية المعلنة من الفشل الذريع في إدارة البلاد على جميع المستويات طيلة 10 سنوات من سقوط النظام السابق في 2011.
المجتمع الدولي الذي اتجهت له الأنظار لمعرفة إن كانت إجراءات رئيس الجمهورية قفزة في الهواء، قالت كلاما خجولا، فهو لم يوصد الأبواب أمام تدابير الرئيس التونسي، لكنه لم يتركها مشرعة دون ضوابط، فالأمم المتحدة طالبت بحل النزاعات والخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن العنف، والبيت الأبيض -وهو الأهم- لم يحدد ما إذا كان ما حدث انقلابا، وفرنسا اكتفت بالدعوة لاحترام سيادة القانون وعودة النظام الديمقراطي، والاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام الدستور، والجامعة العربية تحث على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة.. الخلاصة أن المجتمع الدولي لم يرفض تدابير الرئيس، وإن طغى على الخطاب الحذر والترقب.
المخاوف تسود، وإن كان رئيس الوزراء هشام المشيشي سلّم بالأمر الواقع، وتعهد بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، وعزا الصعوبات التي واجهت الحكومة إلى المنظومة السياسية المتشنجة والفاشلة على حد وصفه.
وأيضا حركة النهضة دعت جمهورها إلى الهدوء، ونفت منع زعيمها الغنوشي من السفر، أو أنه قيد الإقامة الجبرية، إلا أن الأمر لم ينتهِ، والأزمة لم تطوق، والفرقاء لم يرفعوا بعد الراية البيضاء تسليما بقدر الرئيس قيس سعيد.
سيناريوهات ما بعد التدابير الاستثنائية لا تنتهي، بعضها متشائم يربط ما جرى بانقلاب يقوده رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الدول المضادة لثورات “الربيع العربي”، التي سعت وعملت وراهنت على إجهاض آخر تجربة ديمقراطية في العالم العربي، ويستحضرون مآلات الوضع اليمني والليبي والسوري، ويسلطون الضوء أكثر على ما حدث في مصر، وهي مقاربة لا تجد قبولا، ويستذكرون أن الجيش التونسي مختلف، وكان حاضنا للثورة، ولم يدخل في لعبة التجاذبات السياسية.
أما السيناريو الأكثر تشاؤما، والأكثر مدعاة للقلق، استحضار التجربة الجزائرية وعشرية الدم، والحرب الأهلية التي نخرت البلاد.
تونس مقبلة على ولادة من الخاصرة، ومخاض صعب؛ فالرئيس الذي يحظى بتأييد شعبي لم يكن قبل فوزه شخصية سياسية معروفة، وحاضرة، وهو الآن يحكم قبضته على السلطة، والسؤال المصيري هل سيعود إلى الاحتكام للدستور، وقواعد اللعبة الديمقراطية، فيخرج بتسوية سياسية بعد شهر من قراراته وتدابيره الاستثنائية، ويُعين رئيسا للوزراء قادرا على كسر حلقة الاستعصاء؟ هل يُعيد البرلمان للعمل بعد 30 يوما؟ فيُنهي حالة التصعيد والمكاسرة السياسية، وهل تتحرك منظمات المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام للشغل، “القوة الوازنة” التي أنقذت البلاد في “مرحلة الاغتيالات”، وقدمت حلولا توافقية أبقت تونس على سكة المسار الديمقراطي.
ما هي السيناريوهات الممكنة في ظل هذه الأزمة العاصفة؟ هل سيكون الحل والمخرج بانتخابات مبكرة، وحكومة تصريف أعمال يختارها الرئيس كمخرج؟ أم يجنح سعيد للحكم منفردا، فيقلب الطاولة على الجميع، وينقلب على قواعد الحكم الديمقراطي، ويلجأ إلى تقييد الحقوق والحريات، ويفتح الباب للمساءلة والملاحقة على قضايا قد يُشتم منها رائحة انتقام، أو السعي للاتهام وحرق الصورة، والتجييش الشعبي، وبذلك ينقلب على قواعد الحكم الدستوري؟
وربما السيناريو الآخر، والأخير، أن يتدخل الجيش للسيطرة على الوضع المتفجر والمحتقن؛ فيعزل الجميع، ويفرض الأمر الواقع، ويبحث عن تفاهمات جديدة، قد يكون في مقدمتها تعديلات دستورية تُغير طابع نظام الحكم.
قلبي على تونس التي أحبها، وأقف مع الديمقراطية، وضد الانقلاب عليها، وسأبقى مع خيارات الشعب التونسي، وسأظل في كل وقت ضد الاستبداد.
الحرة
———————————-
هل سقطت آخر قلاع الديمقراطية العربية؟/ ياسين أقطاي
هناك نموذجان ومحوران سياسيّان قائمان بالفعل في العالم الإسلامي؛ المحور الأول يتطلع نحو نموذج سياسي يميل نحو الديمقراطية ويعتمد على إرادة الشعوب. أما المحور الثاني، فيؤسس لنموذج سياسي يعتمد على الأنظمة الاستبدادية ويحاول خنق التحولات الديمقراطية من خلال الانقلابات وتفجير الثورات المضادة.
تاريخ هذين النموذجين السياسيّين ضارب في مسيرة الحداثة، ولقد كان النموذج الثاني منهما يسيطر على سائر دول العالم الإسلامي بما فيها تركيا، لكن بفضل ما نسميه “الثورة الديمقراطية الصامتة” التي شهدتها تركيا منذ العام 2002، وما أعقب ذلك من “الربيع العربي” عام 2010؛ تحوّل الطموح السياسي الديمقراطي إلى خيار حقيقي وجاد. وعندما بدأ هذا النموذج الحديث بتشكيل خطر على الأنظمة الاستبدادية تحرّكت تلك الأنظمة من أجل إيقافه من خلال الانقلابات والثورات المضادة.
انطلق الربيع العربي من تونس عام 2010، سرعان ما غزا العالم العربي كله بتأثير الدومينو خلال وقت قصير. إلا أنه وللأسف توقف أولاً في سوريا، ثم مصر ثم ليبيا واليمن، وذلك من خلال تخطيط وتدبير الأنظمة الاستبدادية للانقلابات والثورات المضادة. ومع ذلك وعلى الرغم من نجاح الأنظمة الاستبدادية في إيقاف عمليات التحول الديمقراطي إلا أنها لم تأت بأي بديل ناجح، بل على العكس، انظروا إلى أي مكان شهد ثورة مضادة ستجدوا حالة الفوضى الكاملة التي يغرق فيها النظام والعباد؛ إذ لا تملك الأنظمة الجديدة سوى معاقبة الشعوب بلا رحمة في سبيل صدّهم عن سبيل التحول الديمقراطي العادل.
انظروا إلى سوريا، واليمن، ومصر، وليبيا… مع ملاحظة أن الوضع في ليبيا بات مختلفاً؛ حيث بدأت البلاد تشهد مؤخراً موجة رياح ربيعية ثانية، بفضل التدخل التركي هناك. وبمساهمة من تركيا وبطلب من الشعب الليبي، مُنع الانقلاب المدعوم من المحور القديم ذاته، لتبدأ عملية سياسية في ليبيا يمكن أن تتمخض عن احتضان الشعب الليبي بأكمله وتسلّم ليبيا لليبيين.
من جهة أخرى، لم ينج من موجات الثورات المضادة إلى وقت قريب سوى تونس، مهد ثورات الربيع العربي، حيث كانت البلد الوحيد الذي أقام نظاماً ديمقراطيّاً راسخاً يعمل بشكل لا بأس به. كانت تونس هي القلعة الأخيرة للثورات العربية والمكان الوحيد الذي لا يزال يحتضن روح ذاك الربيع؛ ولهذا السبب بالتحديد أولت القوى الانقلابية اهتماماً خاصّاً من أجل إسقاط القلعة الأخيرة. ولقد كان وجود واستمرار النموذج الديمقراطي الذي أفرزه الربيع العربي مزعجاً لتلك القوى. ولذلك كانوا مهتمين للغاية بإنهاء العملية الديمقراطية في تونس عبر انقلاب.
خنق الديمقراطية التونسية
لم يكن سرّاً على الإطلاق وجود محاولات وجهود خاصة منذ فترة طويلة من أجل خنق التجربة الديمقراطية في تونس من خلال انقلاب. ولقد كان هناك بالفعل برنامج لهذا الغرض خطوة بخطوة. في البداية قاموا بشيطنة حركة النهضة من أجل خلق انطباع قوي وإحباط بين الناس حول أن العملية الديمقراطية البرلمانية لا تحقق تحسّناً ينعكس على الشعب، بل تغرق البلاد في أزمات أمنية، وما تخلل ذلك من مظاهرات مصطنعة في الشوارع، ولم تكن تلك الخطوات وغيرها في النهاية إلا تمهيد الطريق للانقلاب. ومع ذلك لم يكن من المتوقع أن يتدخل الجيش بشكل مباشر للسيطرة على الموقف.
ربما كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر تعقيداً، إلا أن استخدام رئيس منتخب من أجل تمرير الانقلاب يشير في الحقيقة إلى أيّ نوع من المؤامرات يمكن أن يخطط العقل الانقلابي؛ حيث إن الانقلاب الذي يقوم به رئيس منتخب يستمد شرعيته من أصوات الشعب، على برلمان منتخب من قبل الشعب أيضاً؛ ما هو في الحقيقة إلا انقلاب على العملية الانتخابية ذاتها واغتيال لها قبل أي شيء.
لا يمكن أن يكون مثل هذا الانقلاب في صالح الدولة، ولا في صالح رئيس منتخب من قبل الشعب؛ لأن هذا الانقلاب يقضي بشكل خطير على شرعية الرئيس ذاته.
يقول الرئيس إنه يعتمد في قراره حول تعليق البرلمان، على المادة 80 من الدستور التونسي. وتشير تلك المادة بشكل واضح إلى بعض الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن يتخذها الرئيس، ولكن في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.
إلا أنه لا يوجد أي وضع من تلك الأوضاع الخطيرة والمهددة لكيان الدولة الآن في تونس، ولنفترض أن البلاد تمر بهذا الوضع، فمن الواجب على رئيس الجمهورية، كما تنص المادة 80 ذاتها، أن يستشير في ذلك المعنيين الآخرين. وعلى الرغم من أن جزءاً من الحكومة التي كانت مسؤولة عن حكم البلاد عُيّنت بشكل مباشر من الرئيس قيس سعيد ذاته، إلا أن الأخير تعامل معها كقائد معارضة ضدها ومنعها من العمل عبر التدخل المباشر الذي أعلنه.
في الواقع لم يكن من المفاجئ أن نيّة الرئيس التونسي سعيد، الذي كان يتصرف بغرابة شديدة في الآونة الأخيرة، هي خلق الفوضى عبر الوضع الذي تسبب به من تعطيل للبرلمان واستيلاء على الحكومة، إلا أنه لم يكن متوقعًا أن يقدم على هذه الخطوة بهذه الطريقة وهو رئيس للجمهورية وبإمكانه العمل بسهولة مع الجهات السياسية الفاعلة الأخرى، لكن من الواضح أن لديه أجندة مختلفة عن ذلك تماماً.
قيس سعيد على طريق نجدت سيزر
يذكّرنا قيس سعيد تونس في الواقع بأحمد نجدت سيزر تركيا، الذي لم يكن يعرفه أحد قبل انتخابه، وبينما كانت مرجعية سيزر خلال خطابه هي الديمقراطية والحريات، اعتمد سعيد أيضاً في خطابه على رسائل وطنية معادية للاستعمار وملتزمة بدعم القضية الفلسطينية.
منذ اللحظة التي وصل فيها سعيد إلى السلطة بدأ يفاجئ الجميع بتحوّله من ممثل لشعبه إلى ممثّل لنخب أجنبية. آخرها كان زيارته غير المتوقعة إلى ليبيا، فقد أصيب من علم بسبب الزيارة الحقيقي بالذهول، حيث لم تكن سوى زيارة شبيهة لزيارة يجريها سفير فرنسي إلى بلد لنقل رسائل فرنسا. وبات واضحًا أن فرنسا التي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الإدارة الليبية الحالية، قد وظّفت الرئيس التونسي كوسيط.
في النهاية، من المؤكد أن هذا الانقلاب، الذي لم يصدر باسم الشعب التونسي ولن يجلب ذرة من فائدة لهذا الشعب، لا يهدف إلا إلى إنهاء الإيمان بأي عملية ديمقراطية في البلاد، ويجعل الشعب التونسي يندم ألف مرة على طموحاته الديمقراطية.
إن قيام الجهات الفاعلة في السياسة الانقلابية ضد العمليات الديمقراطية، مثل فرنسا والإمارات والسعودية، باستخدام رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب لتنفيذ انقلاب رخيص بهذا الشكل، يُظهر أبعاد العقل الماكر الذي أنتج هذه الانقلابات.
إلى جانب ذلك، فنحن أمام نموذج منافق مزدوج يحكم هذا العالم، وهو أن ما يسمى بالعالم الديمقراطي الحديث لا يريد أبداً رؤية الديمقراطية في العالم الإسلامي، بل يفضّل التعاون مع الانقلابات والقوى المناهضة للديمقراطية.
عربي بوست
———————————–
أخطاء أم خطايا.. كيف ساهم حزب النهضة في أزمة تونس الحالية؟/ أحمد محسن
حتى كتابة هذه السطور، وبعد يومين من تصدّر تونس عناوين الأخبار عقب القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الأحد 25 يوليو/تموز، التي نُظر إليها باعتبارها “انقلاباً”، أو في أحسن الظروف تأويلاً غير سليم للدستور التونسي، فإنه يمكننا القول إن حزب النهضة قد وقع في 3 أخطاء رئيسة أسهمت في اشتعال هذه الأزمة، كما أسهمت في تحديد المسار الذي سارت فيه.
أخطاء حزب النهضة
الخطأ الأول لحزب النهضة هو خطأ استراتيجي بدأ مع بداية الثورة التونسية وظل مستمراً طوال العقد الماضي، وهو مرتبط بمشروع الحزب السياسي نفسه والأولويات التي وضعها للمرحلة الانتقالية. هذا الخطأ هو فصل المطالب السياسية عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الفصل هو خطأ استراتيجي، فالديمقراطية لدى السياسي مهمة لأنها تضبط قواعد اللعبة السياسية، ولكنها لدى المواطن مهمة إذا كانت قادرة على أن تعمل بصورة جيدة فتوفر الوظائف للعاطلين، وتجلب العدالة للمظلومين، وتخفف حدّة المشاكل الاجتماعية التي يعيش فيها المواطنون؛ ففي نظر المواطن العادي، الديمقراطية ليست مهمة في ذاتها، بل مهمة بما تقدمه له من مزايا وخدمات.
فإذا كانت الانتخابات تتم بنزاهة، والأحزاب تتنافس بشراسة، وتتغير الوجوه السياسية من دورة إلى أخرى من دون أن يكون ذلك مصحوباً بأي تغيير في مستوى حياه الناس ومعيشتهم، فلن يكون من المستغرب أن تبدأ قطاعات واسعة من المواطنين التشكيك في الديمقراطية، والتساؤل عن الفرق بين النظام الديمقراطي الحالي والنظام الاستبدادي السابق. حزب النهضة جعل هدفه الأساسي ضمان حدوث انتقال ديمقراطي، وهو مطلوب سياسي مهم بامتياز، ولكنه تناسى في الوقت نفسه أن نتيجة هذا الانتقال الديمقراطي يجب ألا تقتصر على ضمان نزاهة الانتخابات، بل يجب أن تشمل أيضاً ضمان التحسن في حياة المواطن التونسي. ونتائج الدورة السادسة للبارومتر العربي التي صدرت في 2021 أظهرت أن هناك واحداً من كل 10 أو أقل، بين التونسيين، يقول إن الأوضاع الاقتصادية إيجابية في البلاد، في حين قال ثلثا التونسيين إنهم يخشون فقدان مصدر دخلهم في غضون 12 شهراً المقبلة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون من المتوقع أن يبدأ الناس التساؤل عن جدوى الديمقراطية إذا لم تكن قادرة على تحسين حياتهم.
الخطأ الثاني الذي وقع فيه حزب النهضة هو خطأ تجلّى خلال الأشهر القليلة الماضية وأظهر بشكل كبير أن الحزب غير قادر على التفاعل مع المشهد السياسي الجديد. فالنهضة تبنّت استراتيجية دائمة من الحوار والتفاوض وعقد التحالفات السياسية مع الفرقاء السياسيين من أجل الخروج من الأزمات السياسية وضمان الانتقال الديمقراطي، وشرط نجاح هذه الاستراتيجية هو رغبة الأطراف السياسية الرئيسية في عقد مثل هذه التفاهمات والتوافقات، فرغبة طرف واحد في عقد مثل هذه التفاهمات غير كافية، بل يجب أن تكون مصحوبة برغبات مماثلة من الأطراف الأخرى. والقدرة على الاتفاق على حزم سياسية تضمن الخروج من الأزمات السياسية كانت سمة في المشهد التونسي بعد الثورة، وهي سمة غابت عن كثير من البلدان العربية.
ولكن تصرفات قيس سعيّد خلال الشهور الأخيرة أوضحت أنه ليس لديه هذه الرغبة في عقد الاتفاقات، فالرجل يحقق مكاسب بخطابات فارغة المضمون لكنها مرتفعة الصوت، وهو يهتم بالأداء التمثيلي والمظهري أكثر من اهتمامه بالأداء السياسي والخدماتي. ثم إنه أظهر في مرات عدة رغبته في تجاوز الدستور. فإذا كان الرجل الجالس في رئاسة الجمهورية التونسية أظهر مثل هذه الرغبات في تجاوز الدستور، وليست لديه رغبة في عقد تفاهمات سياسية، ويقتات من المزايدة والخطابات الشعبوية، فكل هذه مؤشرات تدفع النهضة إلى مراجعة استراتيجيتها، ليس بالضرورة من أجل استبدالها باستراتيجية أخرى، ولكن من أجل التفاعل مع هذا الوضع الجديد بآليات ووسائل مختلفة عن تلك التي كانت معتادة في الماضي.
وفي الأشهر الأخيرة، بدت النهضة كأنها اعتادت شكلاً معيناً من السلوك والتصرفات السياسية، وأنها غير قادرة على التفاعل مع السياق الجديد الذي يتكون في تونس، وبدل من أن تكون في خانة الفعل فإنها بقيت في خانة رد الفعل، على أمل تجنب السيناريو الأسوأ، ولكن هذا لم يحدث مع الأسف.
وهذا ينقلنا إلى الخطأ الثالث المتمثل في جملة أخطاء تنفيذية بامتياز مرتبطة بتصرف النهضة في ليلة صدور قرارات قيس سعيّد. فالدقائق الأولى في مثل هذه الأزمات السياسية تكون حاسمة في تحديد مسارها، ولكن النهضة في الساعات الأولى سكنت في خانة رد الفعل البطيئة على نحو غريب، إذ أقام الحزب اجتماعاً في ليلة الانقلاب استمر ساعات ليخرج بقرار تم تنفيذه قبيل الفجر.
وبينما كان هناك علامات للارتباك، وتساؤل عما إذا كان الجيش والداخلية سوف يستجيبان لقرارات قيس سعيّد، وما إذا كانت هناك معارضة داخل هذه المؤسسات لمثل هذه القرارات، فإن سعيّد بعد أن أصدر الأوامر إلى الجهات المختلفة، تحرك بنفسه ليتثبت من أن هذه الجهات ستقوم بتنفيذ ما هو مطلوب منها، وعمل على أن يقضي بنفسه على أي إمكانية للتردد أو التلكؤ يمكن أن تحدث داخل هذه المؤسسات. ولكن في هذه الليلة، بدا التراخي والترهل ظاهرين في أداء الحزب والغنوشي معاً.
فإذا كان الحزب قد اتخذ قراراً بالتوجه إلى مجلس النواب فليس أقل من استدعاء أغلب أعضاء الكتلة البرلمانية للنهضة (فضلاً عن الأحزاب الأخرى) للذهاب مع الغنوشي بدلاً من أن يظهر المشهد في النهاية في صورة رجل عجوز وامرأة وجمع صغير من الناس يستجدي ضابط الجيش لفتح أبواب مجلس النواب. وإذا كان هناك قرار باعتصام رئيس الحزب أمام مجلس النواب، فأين الجموع التي ستقف إلى جانبه وتدعمه في هذا القرار؟ لقد كانت هذه القرارات متأخرة، وكانت سيئة في تنفيذها أيضاً. الغنوشي سياسي مخضرم، وعاصر تجارب سياسية مختلفة ومرّ بأزمات سياسية متعددة استطاع الخروج منها بأقل الخسائر، لكنه في هذه الليلة بدت عليه آثار المرض والسن معاً. أما الحزب، فقد أظهرت هذه الليلة أن ماكينته لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
المتسبب الحقيقي
لا ينبغي لمثل هذه الأخطاء التي صدرت من حزب النهضة أن تنسينا المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة، إنه قيس سعيّد وقرارته. لقد وقع حزب النهضة في أخطاء ذكرنا بعضها لكن قيس سعيّد وقع في خطيئة بتجاوزه الدستور وتعطيله المؤسسات المنتخبة، واستغلاله آلام الناس المعيشية والاقتصادية من أجل تعزيز قبضته على السلطة. في كل الأحوال، ما زلتُ أظن أن تونس لديها إمكانية للخروج من هذه الأزمة بخسائر أقل كثيراً من دول أخرى مجاورة، ونتمنى أن تحوّل الأيام المقبلة هذه الأمنية إلى حقيقة.
———————————-
قيس سعيد والانقلاب على الديمقراطية/ رضوان زيادة
بعد وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج عام 2019 احتفت به وسائل الإعلام العربية بوصفه أحد القادمين إلى السياسة لكنه ليس سياسيا كما كان يردد هو نفسه، اتصف بشعبوية محببه عبر تواضعه وهو ما دفعني للكتابة عنه حينها: “حضر الرئيس التونسي المنتخب حديثا، قيس سعيد، بكثرة على وسائط التواصل الاجتماعي. تثير تصرفاته تأييدا كثيرا، مثل توقفه للحصول على القهوة من المحل الذي اعتاد عليه قبل وصوله إلى قصر قرطاج، استقباله الشباب التونسي القادم على أقدامه من ولايات بعيدة بحثا عن العمل، استقبلهم في قاعة كبار الزوار، وودعهم بحفاوة وعناق وكأنهم من أبنائه، خطّه لتكليف رئيس الحكومة الجديد، الحبيب الجملي، بخط كوفي رائع، يعكس تمرّسه في القانون الإداري والدستوري، وأيضا الخط الكوفي. هذه كلها وغيرها إشاراتٌ تعكس التواضع الكبير الذي يحمله الساكن الجديد للقصر، بعكس الصورة التي ترسم عن رؤساء عرب يتصفون بالعجرفة والاستحقار للشعب، والأهم لموقعهم العام لخدمة مصالح شخصية، مثل الإثراء أو تعزيز السلطة الخاصة والشخصية لهم ولأبنائهم، أو تدمير معارضيهم بطرق غير مشروعة للحفاظ على مواقعهم”.
لكن مع مرور الأيام كان واضحا أن سعيد لا يدرك عمل هذه المؤسسات السياسية التي أنجحت التحول الديمقراطي في تونس وأنه ربما بجهل أو عن تعمد إنما يهدف إلى تدميرها، وهو ما حصل بالفعل عندما قام بتجميد عمل البرلمان وسحب حصانة النواب وإقالة الحكومة حيث يمتلك رئيس الحكومة في الدستور التونسي عام 2012 الصلاحيات الأعلى بوصفه نظاما برلمانيا مختلطاً.
انقلاب سعيد على المؤسسات التي أوصلته إلى السلطة وتكييف الدستور وفق ما يرغب ويرى يعكس أن تونس ما زالت في مرحلة هشة من عملية الانتقال الديمقراطي بالرغم من دورة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الدورية التي جرت، لكن معظم علماء السياسة يعتبرون أن استقرار المؤسسات الديمقراطية يحتاج على الأقل إلى أربع دورات تشريعية انتخابية تجري فيها الانتخابات بحرية ونزاهة تامة، وهو ما يعكس فشل هذه النظرية في الحالة التونسية.
فما كان يميز الانتخابات التونسية هو عزوف الناخبين عن المشاركة مما يدل على فقدان الثقة في أن نتائج الانتخابات ستحدث أي تغيير على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناخبين، وهو ما يخيف بأن يتحول هذا الصمت الانتخابي إلى عمليات احتجاج خارج الصندوق الانتخابي على شكل مظاهرات من الصعب السيطرة عليها أو أعمال شغب. وهو ما حصل بالفعل مع عدم قدرة الحكومة على الاستجابة على الصعوبات الاقتصادية وجائحة كورونا.
عموما تحدث كل هذه الهزات السياسية كما يقال عليها في كل الدول حديثة العهد بالديمقراطية وهو ما حدث تقريبا مع خسارة معظم الأحزاب الثورية والديمقراطية في المراحل الثالثة أو الرابعة من الانتخابات التشريعية في أوروبا الشرقية، رغم دور هذه الأحزاب الكبير في عملية التغيير الديمقراطي ودمقرطة المؤسسات بعد مرحلة الاستقلال من الاتحاد السوفيتي والتغيير الكبير الذي جرى عام 1989 حيث خسرت منظمة التضامن البولندية، والسبب الرئيسي يعود إلى التوقعات الكبيرة التي تكون لدى المواطنين أن التغيير السياسي الكبير سيجلب معه نجاحا اقتصاديا وازدهارا على المستوى الوطني والفردي، وبالطبع لم يتحقق شيء من ذلك على المستوى الوطني في تونس حيث يثقل الدين العام الخزينة التونسية وهو ما يجبرها على الاقتراض بشكل دائم من البنك الدولي دون أن تعوض إيرادات السياحة أو تصدير الفوسفات من العجز الدائم في الميزانية أو يرفع نسبة النمو المنخفضة جدا على مستوى الأعوام الأربعة الماضية نسبة 2.1 وفقا للبنك الدولي، وفوق ذلك يبقى ترهل مؤسسات القطاع العام أو التوظيف الحكومي أحد أهم عقبات النمو والإصلاح الاقتصادي والتخلص من ذلك يكون عبئاً على كل مرشح ديمقراطي يريد أن يعد الناخبين بالتوظيف وفرص العمل.
وهو ما أدخل تونس في حلقة مفرغة من العجز الاقتصادي الذي يصبح أكثر تأثيرا مع ارتفاع نسب التعليم فالنسبة الأكبر من المتعلمين صوتوا للمرشح قيس سعيد الذي اعتمد على طلبته في إدارة الحملة الانتخابية المتواضعة التي أوصلته إلى الموقع الأول، في حين صوت الناخبون الأقل تعليما للمرشح نبيل القروي الذي حصل على المرتبة الثانية.
ربما نسخة المرشح قيس سعيد تختلف كليا عن نسخة الرئيس الذي انقلب على الدستور الذي أوصله إلى السلطة في عام 2019.
تلفزيون سوريا
—————————
تونس الثورة… مرة أخرى!/ د.خالد باطرفي
في خريف 2011 أنطلقت أولى الثورات العربية مع إشعال شاب فقير النار في جسده احتجاجاً على مصادرة الحكومة لمصدر رزقه الوحيد، عربة بيع خضار. واندلعت النيران بعدها في الدول العربية المجاورة بدعم مباشر من مشروع أميركي كان ينتظر الشرارة الأولى لإعادة صياغة المنطقة العربية بحيث يتم التخلص من الحلفاء والشركاء الأُول، وتسليمها لإدارة جديدة، تمثلت في أحزاب وميليشيات الإسلام السياسي المهادنة للغرب وإسرائيل، رغم خطابها التعبوي المقاوم، وأبرزها، جماعة “الإخوان المسلمين”، برعاية تركيا، و”حزب الله”، برعاية إيران.
ما بعد الثورة
بعد نجاح الثورة التونسية بعامين، زرت العاصمة، ولي فيها أصدقاء وأحبة، وكان أول ما لمسته فرحة الشعب بحرية التعبير والتظاهر والتنفيس عن الاحتقان ضد فساد وصرامة النظام السابق. ورافق ذلك أحلام وأمنيات عالية السقف … وشكاوى من انفراط الأمن في بعض المناطق، وتخبط الحكومة الجديدة، وتضارب أجندات الأحزاب.
سألني الأصدقاء عن انطباعي الأول، فقلت بصراحة أزعجت بعضهم: كنت في الزيارات الماضية اشكو أحياناً من جفاف موظفي المطار، رغم مهنيتهم العالية، وفي هذه الزيارة شكوت من طراوة بعضهم وتلميحه بدفع “بخشيش” من تحت الطاولة لخدمة أفضل وأسرع.
في الزيارة التالية، عام 2017، انتابني حزن وألم. فبعد سنوات من الثورة، لم تستقر الأوضاع الأمنية والإدارية والاقتصادية، والنتيجة انتكاسة كبيرة للسياحة والتجارة والزراعة. وتسبّب ذلك في ارتفاع نسبة البطالة، التي كانت شبه معدومة قبل الثورة، الى أرقام قياسية، وتزايد الحوادث الإرهابية والأمنية.
العديد من المرافق السياحية والفندقية التي كانت في العقد الأول من الألفية الثانية تعج بالحركة والحيوية، أصبحت رمادية، هامدة. والأسواق التي كانت تلتهب نشاطاً، أضحت راكدة. وحدها الشوارع والساحات التي تشهد التظاهرات بين حين وآخر، والصحف والقنوات التي تحررت من قيود الرقيب، تبدو حية وفاعلة.
إستراتيجيا السياحة
قال لي المرشد السياحي: “أنتم الخليجيون والليبيون كنتم تزورونا، وتبقون وقتاً أطولَ وتنفقون أكثر من الأوروبيين. ولكن نتيجة للاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية في سنوات ما بعد الثورة، لم يبقَ لنا إلا الجيران الأفارقة، الأقل قدرة على الإنفاق، إضافة إلى زيادة السياح الروس، وهم في المجمل لا يغطون ربع ما فقدناه من تعداد ومردود.
السياحة هي المصدر الثاني للدخل القومي بعد الزراعة، وأكثر من الفوسفات والصناعة والخدمات. كان يزورنا 7 ملايين سائح، واليوم هبط الرقم الى النصف. نحن بحاجة إلى عودتكم إلى بلدكم الثاني، تونس”.
كنت أحد أولئك الزوار المنقطعين. فقد زرت تونس الخضراء مراراً منذ ثمانينات القرن الماضي. وقتها، كانت البنية التحتية أقل تطوراً مما هي عليه اليوم، ولكنها كافية لتلك المرحلة الزمنية واحتياجاتها التنموية.
في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ركزت الإستراتيجية الوطنية على السياحة، وأنشأت شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديد والنقل الخفيف والمطارات والموانئ والاتصالات، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية المهنية والسياحية.
واستقطب القطاع السياحي الاستثمار الخليجي والأجنبي بمليارات الدولارات. فعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، كالحمامات وسوسه، بنيت مئات الفنادق والمنتجعات وصولاً إلى ربع مليون وحدة سكنية سياحية، في 2010.
حكومة “الإخوان”
قال لي حقوقي تونسي في عهد الرئيس المستقيل، زين العابدين بن علي، إن الحكومة تعلم أن الشعب لن يثور إلا إذا افتقد حاجاته المعيشية الأساسية. فطالما بات المرء “آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه”، فسيقبل بأي نظام ويرضى بأي حاكم.
يبدو أن حكومة “الإخوان المسلمين” لم تدرك هذه الحكمة، وانشغلت كما في كل تجربة حكم، الى تثبيت سلطة حزبها وإثراء قادتها وتقوية أحلافها مع تركيا وإيران، والحكومات “الإخوانية” الأخرى. رأينا هذا في مصر، وغزة، والسودان، وليبيا، والمغرب، كما نراه اليوم في تونس. ركبوا موجات الثورات العربية، وباعوها للعجم، ثم فشلوا، وخسروا، ورفضوا الخسارة فخسروا أكثر.
وهكذا تدهورت أحوال التوانسة الى درجة أن لا يجد الطالب مقعداً، والمريض سريراً، والعامل وظيفة، والتاجر زبوناً. وتشير الأرقام الرسمية الى تقلص حجم الاقتصاد بنسبة 12 في المئة ووصول البطالة الى 36 في المئة بين الشباب، و ارتفاع نسبة الدين العام الى اجمالي الدخل القومي 90 في المئة.
ثم جاءت جائحة كورونا لتكشف تدهور النظام الصحي في البلاد لدرجة عدم القدرة على استيعاب وتوزيع وتوظيف المساعدات الإنسانية التي تجاوبت بها دول العالم، من السعودية ودول الخليج الى أميركا ودول أوروبا، مع نداء الرئيس قيس بن سعيّد. ملايين أمصال التطعيمات وأجهزة الأوكسجين وتجهيزات المستشفيات وحتى الكمامات والأدوية وصلت الى مطار قرطاج، وعجزت أجهزة الحكومة عن الاستفادة منها. وعندما اضطر الرئيس للاستعانة بالجيش للقيام بالمهمة، صاح رئيس الوزراء وناح الائتلاف الحاكم واعترض حتى وزير الصحة المقال على هذا الخرق الخطير للدستور وفصل السلطات واختصاصات الحكومة!
الثورة الثانية
خرج الشعب غاضباً، مزمجراً ومعه ألف حق. وقام الرئيس بما كان يتوجب عليه القيام به، فعطّل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس الوزراء وبعض وزرائه، وتسلم بدعم من الجيش وقوات الأمن أعمال الدولة بمشاركة رئيس وزراء جديد يتم اختياره خلال ثلاثين يوماً. وبعد مواجهات دموية بين اتباع “الإخوان” والشعب، صدر قرار بحظر التجول والتظاهر، وأعلن الرئيس أن أي رصاصة تطلق على الشعب سيرد عليها حماة الوطن بوابل من الرصاص.
لم تبقَ للجماعة منصة قانونية لتحدي الإجراءات بعد إغلاق البرلمان، فلا سلطة تنفيذية ولا تشريعية. ورئيس الوزراء قبل الإقالة أعلن تعاونه مع الرئيس حتى اختيار البديل. ومن مفارقات القدر أن المحكمة الدستورية التي كان في إمكانها حسم قانونية القرارات الرئاسية ومدى مطابقتها للفصل الثمانين في الدستور تسبّب “الإخوان” في تعطيل قيامها.
رحبت بعض الأحزاب ومنها حزب “التحالف من أجل تونس”، و”حركة الشعب التونسية”، و”التيار الشعبي”، وأعلنت أخرى الرفض والمواجهة، وعلى رأسها “حزب النهضة” والحركات السياسية المقربة مثل ائتلاف الكرامة. وقبلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بالإجراءات ورفضت اعتبار ما حدث انقلاباً، ودعت السعودية المجتمع الدولي للمساهمة في دعم خيارات الشعب التونسي وتقديم العون لقيادته.
دروس التاريخ
بدا وكأنما يعيد التاريخ نفسه. ففي عام 2013 خرج الشعب المصري ثائراً على حكومة “الإخوان” التي هوت بخزينة البلاد الى القاع، حتى كادت مصر تعلن الإفلاس، وفشلت في تقديم أبسط الخدمات الأساسية من أمن وطعام وكهرباء ووقود.
استجاب الجيش بقيادة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس محمد مرسي، واعتبره “الإخوان” حليفاً، فأقال الحكومة المنتخبة، وعطّل الدستور والبرلمان. اعترض “الإخوان” واستنجدوا بأميركا باراك أوباما، وتركيا أردوغان. وانتهت المواجهة الى حل الجماعة وتصنيفها إرهابية وسجن ومطاردة القيادات والناشطين، وتحول الحزب الحاكم الى معارضة منفية في إسطنبول ولندن والدوحة، تعاني اليوم التضييق عليها وترحيل قياداتها وربما تسليم بعضها للحكومة المصرية.
ولحقت بهم الحكومة “الإخوانية” في السودان، بعد عقود من الحروب والفساد وسوء الإدارة، كان من نتائجها فصل جنوب السودان الغني بالنفط والأراضي الزراعية عن شماله، وتدهور قيمة الجنيه الى درجة عدم توفره في البنوك، وضعف الخدمات الحياتية الأساسية وضرب المتظاهرين بالحديد والنار. ثار الشعب وتدخل العسكر وانتهت رموز الحكومة “الإخوانية” إلى السجون أو المنفى. وكالعادة، لم تقبل الجماعة بالأمر الواقع، وواصلت المقاومة والتحدي كفلول للنظام السابق، بدعم من تركيا وإيران وقطر.
واليوم، يتكرر المشهد ويقود “حزب النهضة” التمرد على الرئيس، ويتدخل أردوغان، وتؤلّب قناة “الجزيرة” الشارع التونسي والعربي، ويكرّس أتباع الحزب الانقسام الشعبي والمواجهات الجماهيرية. طريق جُرّب من قبل وانتهى الى غلبة الدولة وهزيمة المتمردين، وتحوّل حزب شرعي الى جماعة منبوذة، مطاردة، ولاجئة في احضان أعداء العرب.
فشل الإسلام السياسي
التاريخ يعيد دروسه على من لا يعيها. والعالم العربي المفتون بفكرة الخلافة وشعار “الإسلام هو الحل” لا يزال بعضه مسحوراً بأصحاب الأفكار الرومانسية المستقاة من ماضي الأمة الإسلامية في أزهى عصورها، ومتجاهلاً لحقائق العالم بنظامه الجديد.
ورغم أن التجارب أثبتت فشل الفكرة، من إيران ودولة “داعش” وأفغانستان، إلى مصر وتونس والسودان، وعجز اصحابها عن تحقيق المعجزات التي وعدوا بها بعد توليهم الحكم لسنوات أو حتى عقود، إلا أن الأكذوبة لا تزال تجد في نفوس البعض قبولاً وتصديقاً. ربما هي ردة فعل على خديعة الثوريين من الاشتراكيين والقوميين والبعثيين العرب، والتردي الذي أوصلوا بلدانهم اليه، وربما أن جيل “الصحوة” الذي وُعد بجنة الله في الأرض، صدق أن الكهنة أصلح الناس لإدارة شؤون الدولة، فسلمهم قيادتها. وربما هو الخوف الذي زرعه الطائفيون فشقّوا به الصفوف وفرقوا الشعوب على خلاف المعتقد والمذهب.
على أننا بعد كل ما جرى ويجري على أبواب يقظة، أو يجب أن نكون. وعلينا أن نطوي فصل “الإسلام السياسي” في تاريخنا الحديث، لنفتح فصول التنمية والتحديث والبناء. فالمتلفت لا يصل، ومن يضع أمسه أمامه لا يتقدم. وعجلة التاريخ لا تعود أبداً الى الوراء.
النهار العربي
—————————-
فورين بوليسي: تونس تمثل امتحانا حقيقيا لأجندة بايدن الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان/ إبراهيم درويش
قال مايكل هيرش المراسل البارز ورئيس تحرير الأخبار في مجلة “فورين بوليسي”، إن الديمقراطية التونسية بحاجة للمساعدة، فهل يتحرك بايدن؟ وأشار في تقريره إلى أن تونس الفقيرة وغير المهمة استراتيجيا تظل مع ذلك الوريث الحي للربيع العربي.
فعلى مدى العقد الماضي انهارت ديمقراطية عربية ناشئة وراء الأخرى ووقعت في يد الطغيان أو صارت ساحة نزاع طائفي أو حرب أهلية، إلا تونس التي كانت الأنجح في البحث عن طرق للتقدم أماما، والتحرك بين خيارين أحلاهما مر أو كما قال الروائي اللبناني- الأمريكي هشام ملحم بين “سيلا الأمن القومي وخاربيدس الإسلام السياسي” كما في الأسطورة الإغريقية.
وفي عام 2015 فازت رباعية الحوار التونسي جائزة نوبل لدورها في تعزيز العملية السياسية التشاركية بعد سقوط نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. لكن التجربة التونسية الحساسة تواجه خطر الفشل والفضل يعود إلى قيس سعيد ومحاولته السيطرة بالقوة على السلطة، حيث عزل رئيس الوزراء وعلق البرلمان وسيطر على مكتب المدعي العام ومنح التجمعات لمدة 30 يوما. وصدر عن العواصم الأوروبية وواشنطن في الأيام الأخيرة توبيخا لطيفا، واختفت تونس من عناوين الأخبار.
وبحسب بيان وزارة الخارجية يوم الإثنين فقد شجع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سعيد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعد ذلك نشر بلينكن تغريدة قال فيها إنه حث الزعيم التونسي على “مواصلة الحوار مع اللاعبين السياسيين والشعب التونسي”. لكن إجراءات سعيد التي اسماها طارئة لا تزال في مكانها وقالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء إنه لن يتم اتخاذ تحركات. وقال متحدث الخارجية للمجلة “نحن نراقب وعلى تواصل”، لكن بعض الناشطين والمحللين في المنطقة يطالبون بضغط قوي. وقالوا إن الحفاظ على الديمقراطية التونسية سيكون بمثابة امتحان لالتزام بايدن بالدفاع عما أسماها “مسألة عصرنا” و “هل تستطيع الديمقراطيات العمل معا وتقديم مكاسب لشعوبنا في عالم يتغير بسرعة”.
ونقل الكاتب عن تشارلس دان، الدبلوماسي الأمريكي السابق وبخيرة واسعة في الشرق الأوسط قوله إن رد إدارة بايدن على الأزمة في تونس هو بمثابة “الجلوس متفرجا”. وأضاف دان أن بيانات صدرت تدعم الديمقراطية لكن لم يتم اتخاذ تحركات حقيقية. وبالمقارنة “رحب المستبدون في المنطقة مثل مصر والسعودية بسيطرة الرئيس التونسي على السلطة”. ويرى نقاد مثل دان أن إدارة بايدن فشلت في تحقيق ما تعهد به بلينكن في خطاب مهم له في 3 آذار/مارس وقال فيه إن السياسة الأمريكية ” ستحفز السلوك الديمقراطي وتشجع الأخرين على القيام بإصلاحات مهمة ومحاربة الفساد”.
وما هو على المحك أمر أكبر من ديمقراطية مختلة وظيفيا في دولة من 12 مليون وتقع على هامش العالم العربي.
ويقول الخبراء إن نجاة الديمقراطية التونسية قد تقدم حلا طويل الأمد للإرهاب الإسلامي. ويرى نوح فيلدمان، من جامعة هارفارد ومؤلف كتاب الشتاء العربي إن حزب النهضة الإسلامي والجزء المشارك منه في الائتلاف هو “هي في الحقيقة عينة امتحان ليس في العالم ولكن العالم الإسلامي بشكل أوسع” و “لو أرادت الإدارة أن تكون جادة بحماية الديمقراطية كنهج في السياسة فهناك بالفعل أماكن قليلة مهمة”، ولن تكلف الكثير كما يقول فيلدمان، لكن التعبير عن عدم الرضى بتحركات سعيد سيظهر أننا “نؤمن بالديمقراطية وأننا لا نتعامل مع الظروف فقط”.
ويرى الكاتب أن تونس مهمة واستثنائية في العالم العربي لأنها البلد الوحيد الذي قرر فيه حزب إسلامي قطع العلاقة مع الحركات الإسلامية المتشددة مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وأدرك قادة النهضة بشكل مبكر أن هذا التنازل استراتيجية مهمة للوصول إلى السلطة.
وأعلنوا في عام 2016 أن الحزب سياسي “خارج أي علاقة بالدين”. وفي تحرك نادر إن لم يكن التحرك الوحيد بين الأحزاب الإسلامية، تخلت النهضة عن مطالب تضمين الشريعة في الدستور العلماني. ونجحت هذه التحركات لوقت حيث أصبح رئيس البرلمان المعلق، هو زعيم النهضة، راشد الغنوشي. وشعر سعيد، وللمفارقة، هو محامي القانون الدستوري، بالدهشة من النقد الدولي، وقد لا يدمر الديمقراطية. وهو مقتنع أن تحركاته صحيحة بناء على المادة 80 من الدستور في حالة تعرض البلاد لخطر محدق، لكن لا توجد محكمة دستورية لكي تفصل في الموضوع، وهذا راجع للشلل السياسي الذي أسهمت النهضة فيه. وفي الوقت الذي صمتت فيه واشنطن والدول الغربية إلا أن الديكتاتوريات والملكيات في المنطقة سارعت بحث سعيد على المضي في طريق الديكتاتورية وتصنيف النهضة كجماعة إسلامية متطرفة.
وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” يوم الثلاثاءإلى أن المعلقين الصحافيين وفي التلفزة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات ومصر اعتبروا تحركات سعيد انتصارا للإرادة الشعبية ضد النهضة، وحاولت الدول الثلاث مع معارضي النهضة في تونس ربطها بالإخوان المسلمين والإرهاب. ويقول ملحم إن “إخوة الديكتاتوريات العربية تريد النمو في وقت ترغب فيه أن يحرم فيه الديمقراطيون العرب من نجمهم العابر”. وكشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس فيرست أن عودة الديكتاتوريات العربية يعمل على ولادة جيل جديد من الإرهابيين. وأدى القمع الذي قام به نظام السيسي إلى حملة تجنيد واسعة لتنظيم “الدولة” في سجون مصر.
ويرى فيلدمان وغيره من المراقبين وكذا ناشطي حقوق الإنسان أن بايدن يمكنه عمل المزيد من أجل توصيل رسالة لسعيد وأن استمرار تدفق الدعم الدولي سيكون مشروطا بالسلوك الديمقراطي. وقبل سيطرة سعيد بفترة قصيرة وافقت مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية على تقديم 500 مليون دولار لتقوية قطاع النقل والتجارة والمياه. وتسعى حكومة سعيد للحصول على قرض 4 بـ مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والذي يتأثر بضغط واشنطن والعواصم الأخرى. وفي 2020 وقعت الولايات المتحدة اتفاقا للتعاون العسكري مدته 10 أعوام مع تونس ويعقد الطرفان مناورات عسكرية مشتركة دورية.
واستثمرت الولايات المتحدة في العقد الماضي مليار دولار في الجيش التونسي، حسب القيادة المركزية الأمريكية في إفريقيا. وعبر نقاد آخرون عن خيبة أملهم من رغبة بايدن للغمز والإيماء إلى الديكتاتوريين في المنطقة مثل عبد الفتاح السيسي والملكية السعودية. ويقول بريان دولي من هيومان رايتس فيرست: “من الواضح أنهم لم يقرنوا القول بالفعل” و “حان الوقت للتوقف عن القول إن من الباكر الطلب من الإدارة، فقد مضى عليها ستة أشهر ولم يظهر منها أي موقف ملموس”. ففي شباط/فبراير وافقت إدارة بايدن على تمرير صفقة 197 مليون لمصر التي سجنت عائلة ناشط أمريكي- مصري. وخارج إطار الدعم الخارجي الذي قد يترك آثاره على بلد فقير مثل تونس، لدى الإدارة أوراق ضغط أخرى مثل تعليق اللقاءات على مستوى عال وكذا اشتراط الدعم بحقوق الإنسان. ولكن الإدارة كما يقول دان “ترددت في استخدامها”.
ورغم اهتمامه بحقوق الإنسان لم يظهر بايدن اهتماما بإحياء ما تبقى من الربيع العربي. وبالمجمل أظهرت الإدارة رغبة بأنها تريد مغادرة المنطقة والتركيز على منطقة الباسيفيك والصين. والرئيس يؤمن بالواقعية السياسية ولا يرغب بتنشئة ديمقراطيات جديدة بقدر تجميع الديمقراطيات الناضجة في جبهة واحدة ضد الصين وروسيا.
وفي أيار/مايو شكر بايدن الرئيس المصري للدور الذي لعبته بلاده في وقف إطلاق النار بين حماس في غزة وإسرائيل. وقد شجع الرئيس الديمقراطية في مناطق أخرى حيث دعا المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفوسكيا إلى البيت الأبيض وتفكر إدارته بفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. ومن الواضح لبراغماتيين مثل بايدن أن الديمقراطية لم تكن مكسبا لتونس، فقد رحب الكثير من التونسيين بخطوات سعيد. ويرى نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر “أعتقد أن الموضوع الأساسي هو أنك بحاجة لاستقرار اقتصادي لو أردت الحصول على ديمقراطية مستدامة”. وتظهر محنة تونس أن الديمقراطية ليست دواء لكل العلل- حتى في الولايات المتحدة وعندما يتعلق الأمر بمواجهة كوفيد-19. ويقول ملحم “الديمقراطية التونسية كانت هشة” و “فشل ذريع للحكم الذي كان واضحا خلال العقد الماضي، عاصفة كبيرة حصلت بالإضافة للخلل السياسي وأصبحت المشاكل الإقتصادية المزمنة خطيرة بسبب فشل النخبة الحاكمة في مواجهة كوفيد-19”. وتعلق ميشيل دان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي “هناك إمكانية لتجنب التونسيين الهاوية كما فعلوا عدة مرات وعندما بدا أن عملية الانتقال ستفشل”، “لكن الحادثة هذه تظهر، مرة أخرى صعوبة نجاح عملية التحول الديمقراطي بدون مناخ دولي داعم. ولا دعم لعملية الانتقال التونسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم قليل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة”. وفشلت الديمقراطية في العالم العربي لعدة أسباب،
الحرب الأهلية في اليمن وسوريا والخوف من الإسلاميين في مصر، ولكن تونس التي بدأت فيها الثورة بموت محمد بوعزيزي عام 2011 ظلت تواصل تجربتها الديمقراطية، فهل ستكون تونس هي المكان الذي سينتهي فيها الربيع العربي؟ لكن بعض الخبراء يرون أن الربيع العربي لم يمت بل هو في حالة سبات. وتحتاج هذه المجتمعات دعما من الخارج. ومصداقية بايدن الداعمة للديمقراطية على المحك، وبخاصة عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما والتي تخلت عن الحركة الديمقراطية في مصر ودعمت سريعا انقلاب السيسي في 2013. ويقول هاشمي “ننسى في العادة أن الثورات الديمقراطية لا تنجح في المحاولة الأولى”
القدس العربي
—————————-
نيويورك تايمز: الغرب أهمل مشاكل الاقتصاد وركز على “النهضة” والإرهاب وحرم تونس من وعود الثورة/ إبراهيم درويش
حت عنوان “الوعد الديمقراطي التونسي يكافح لكي يثمر” قالت كارلوتا غال في صحيفة “نيويورك تايمز”، إن تونس التي قادت ثورة وأطاحت بديكتاتور عام 2011 وأشعلت لهيب الربيع العربي، لكنّ الغرب تجاهل مشاكلها الاقتصادية مركزا بدلا من ذلك على خلق جدار منيع ضد التطرف الإسلامي، بحسب وصف الصحيفة.
وقالت الكاتبة إن تونس بعد عشرة أعوام من الثورة الشعبية، لا تزال تحظى بمديح أنها قصة النجاح الوحيدة التي ظهرت من اضطرابات ذلك العصر، فقد رفضت التطرف والحروب المفتوحة، ومنعت الثورات المضادة، وحصل قادة المجتمع المدني فيها على جائزة نوبل للسلام لدورهم في بناء الإجماع. ورغم كل الثناء، إلا أن تونس البلد الصغير في شمال أفريقيا والتي لا يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، لم تكن قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الخطيرة والتي قادت إلى الثورة في المقام الأول. كما لم تحصل على دعم غربي مؤكد، وهو أمر ربما ساعد على عملية الانتقال من ظلم الديكتاتورية إلى ازدهار الديمقراطية. ويقول محللون وناشطون إن الغرب تجاوز في اللحظة الحرجة من التحول ومحاولة تونس لإعادة بنائها، الكثير من احتياجاتها الماسة، مركزا بدلا من ذلك على قتال التطرف الإسلامي.
واليوم يواجه التونسيون آخر الاضطرابات التي بدأت عندما قام الرئيس قيس سعيد بعزل رئيس الوزراء وتعليق البرلمان، وهي إجراءات قسّمت التونسيين بين داعم وشاجب. وانقسمت الأحزاب السياسية حول قانونية سيطرته التنفيذية على السلطة، فيما يحاول الناشطون ودعاة حقوق الإنسان الحفاظ على سيادة تونس وبقاء أهداف ثورة 2011 حية. ودعوا العالم الخارجي لمراقبة ورصد التطورات في البلد. لكن حقيقة ترحيب التونسيين الذين ملّوا من قادتهم وسط أزمة اقتصادية عميقة وموجة وباء، هي إشارة عن الأوضاع السيئة التي وصلت إليها البلاد.
ونقلت الكاتبة عن فاضل قابوب، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوهايو: “حققنا تقدما ضخما على صعيد الحرية والجبهة السياسية رغم كل الأزمات” و”لكننا أبقينا على نفس النظام الاقتصادي الذي أنتج عدم المساواة وأزمة الديْن التي أدت لاستبعاد اجتماعي اقتصادي ثار عليه الشعب”.
ويعتبر قابوب واحدا من عدة تونسيين يتساءلون عن الطريقة المألوفة التي يتعامل فيها الغرب مع حالات الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. ويقولون إن النهج أنتج مجموعات مصالح مالية وثورات مضادة. وفي تونس يقول قابوب إن “العاصفة التامة على الجبهة الاقتصادية” تتجمع منذ وقت.
ومشكلة تونس الكبرى هي الديْن الخارجي الذي ورثته عن الديكتاتورية السابقة. ومن أجل خدمة الديْن، أُجبرت الحكومات المتعاقبة على التركيز على توفير العملة الصعبة. ومنذ عقد السبعينات من القرن الماضي، شهدت تونس نموا علق بين الشمال العالمي والجنوب، حيث تقوم الدول الفقيرة بتصدير المنتجات الزراعية الرخيصة والمواد الخام مقابل استيراد الطاقة المكلفة والبضائع الصناعية للأغنياء فقط. وكانت النتيجة حفرة لم تكن تونس قادرة على الخروج منها.
ورغم الدعوات بعد الثورة التونسية للحكومة الجديدة لإلغاء “الديون البغيضة” أو غير القانونية (وهي الديون التي راكمها النظام الديكتاتوري وبالتالي فهل ليست محلا للسداد)، قرر المشرعون الجدد في تونس عدم مواجهة الدائنين في أوروبا خشية على العلاقات. كما لم يبذل المشرعون جهودا لتغيير بنية النظام الاقتصادي الذي يستورد أكثر مما يصدر، وعادة ما تدفعه المصالح الخاصة التي تحتكر استيراد سلع خاصة. وبدلا من استخدام أراضيها الخصبة لزراعة القمح، استخدمتها تونس مع المياه لزراعة الفراولة كي تصدرها للخارج، ثم تستورد الطاقة والطعام لدعم صناعة السياحة، حتى بعدما ثبت أن هذا غير قابل للاستمرار بعد الهجمات الإرهابية ووباء كورونا.
ويرى المحلل التونسي محمد ضياء حمامي، الذي درس المرحلة الانتقالية، إن معظم البرامج الاقتصادية التي طُرحت، كانت مثل البرامج التي طبقتها دول أوروبا الشرقية بعد مرحلة الشيوعية، وحملت نفس العيوب، و”لم تمنع ظهور مجموعات المصالح، ولم يكن مستغربا رؤية نفس المشاكل لأن السياسات متشابهة”.
وقالت مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط بجامعة نيويورك- فرع أبو ظبي، ولديها خبرة طويلة في تونس، إن هناك قلة معرفة لدى المسؤولين الغربيين بتونس وهو ما عرقل المساعدة. وأضافت: “لاحظت هذا مباشرة بعد 2011.. لم يكن لدى الولايات المتحدة وبقية الديمقراطيات الغربية أي معرفة بالسياسة التونسية”.
وقالت ماركس إن موضوعات بنيوية مثل إصلاح القطاع الأمني والقضائي والإعلامي ومعالجة البطالة بين الشباب، كانت يجب أن تكون الموضوعات الرئيسية للانتقال بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بديكتاتورية زين العابدين بن علي التي استمرت 23 عاما. إلا أن المسؤولين الغربيين أبدوا هوساً في موضوع الإسلاميين، وخاصة حزب النهضة الذي فاز بالانتخابات، وأين سيذهبون ومن يمثلون؟
وقالت ماركس: “في الحوارات، فإن هذه الأسئلة شفطت الأكسجين من الغرفة. ولم يكن هناك مجال لطرح أي سؤال آخر”. وفي مرحلة أخرى، ركّز الغرب على بناء الإجماع بين القادة السياسيين في تونس، حيث تم منح أربع منظمات جائزة نوبل في 2015، لدرجة تحول الأمر لشذوذ.
وبعد ثورة 2011، أسرع تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة إلى بناء شبكات هناك. وظهر الإرهاب للعلن في 2012 عندما تعرضت السفارة الأمريكية في تونس لهجوم الغوغاء. وتبع ذلك في السنوات اللاحقة خلايا متطرفة قامت بتنفيذ هجمات انتحارية واغتيالات هزت التفاؤل بين التونسيين، وكادت أن تعطل عملية الانتقال الديمقراطي. ووجهت عملية قتل جماعي على منتجع ساحلي ومتحف باردو في العاصمة تونس، ضربةً لقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
ودخلت الولايات المتحدة وقدمت الدعم الأمني الضروري، وقدمت تدريبا ومعدات عسكرية لقوات الأمن التونسية في برنامج كان الأنجح منذ 2001، مع أن التعاون كان سريا حيث لم تكن القوات الأمريكية واضحة. وبحلول 2019، وصل عدد الأمريكيين الذين يدربون ويقدمون النصح لنظرائهم التونسيين إلى 150 ضابطا.
ووصف مسؤولون أمريكيون البرنامج بأنه من أكبر المهام التي قامت بها الولايات المتحدة في قارة أفريقيا. وزادت واشنطن المساعدات العسكرية للبلد من 12 مليون دولار عام 2012 إلى 119 مليون دولار عام 2017. وساعد الدعم الأمريكي تونس على مواجهة التهديد الإرهابي، لكن وزراء الحكومة لاحظوا أن مواجهة الإرهاب وإن لم يكن عنه بد، إلا أنه حرق جزءا كبيرا من الميزانية الوطنية.
ومشكلة تونس الباقية كما يقول قابوب هي بنية الاقتصاد. فكل الأحزاب السياسية لديها نفس الخطط الاقتصادية التي تقوم على معايير التمويل من البنك وصندوق النقد الدوليين. وهي نفس الخطط التي استخدمها بن علي.
وقال قابوب: “في الوقت الحالي، الجميع في تونس يناشدون صندوق النقد الدولي منحهم قرضا، باعتبار أن هذا حل للمشكلة، لكنها مصيدة، وهي مجرد إسعاف أولي لكن العدوى لا تزال قائمة”.
——————————–
الرئيس قيس سعيّد يجمّد عمل البرلمان التونسي، ويعفي رئيس الوزراء من مهامه، ويعزّز صلاحياته القضائية/ حمزة المؤدّب
في 25 تموز/أيلول، بعد يوم من المظاهرات التي اندلعت في تونس احتجاجًا على المشاكل الاجتماعية السياسية التي تعانيها البلاد وسوء إدارة أزمة كورونا، اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلةً من القرارات قضت بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتنصيب نفسه النائب العام للبلاد. وأعلن كذلك عن عزمه تعيين رئيس وزراء جديد مكلّف بتأليف الحكومة.
استند سعيّد إلى الفصل 80 من الدستور الذي يعطي الرئيس صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية “في حالة خطر داهم” يهدّد الأمن القومي، مستغلًّا عدم وجود محكمة دستورية من شأنها تقييد تأويلاته الواسعة للنص الدستوري. وقد اعتبر مراقبون أن خطواته هذه تشكّل انقلابًا على الدستور، ولا سيما أن الفراغ الدستوري الحالي يتيح لسعيّد الاضطلاع بصلاحيات رئاسية وتنفيذية وقضائية استثنائية.
حاول حزب النهضة الإسلامي وحلفاؤه معارضة القرارات الرئاسية من خلال إعادة تفعيل عمل البرلمان. لكن قوات الجيش التونسي التي تحرس البرلمان منعت رئيسه راشد الغنوشي وعددًا من نواب النهضة من الدخول إلى مقر مجلس نواب الشعب. وفي 26 تموز/يوليو، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي قبوله القرار الرئاسي وتخليه عن منصبه واستعداده لتسليم السلطة. أما الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى الرغم من أن بيانه لم يحوِ أي إدانة، فقد ناشد الرئيس بالعودة إلى الإطار الدستوري والديمقراطية.
أين تكمن أهمية المسألة؟
يأتي قرار سعيّد بعد أشهر من الصراع على السلطة بين كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان. فقد أدى الخلاف على التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه المشيشي وعارضه الرئيس إلى وقوع أزمة دستورية لا تزال مستمرة منذ كانون الثاني/يناير الفائت.
وتزامنت خطوة سعيّد أيضًا مع تخبّط البلاد في أزمة اقتصادية فاقمها تفشّي جائحة كوفيد-19. فقد أدّى الصراع على السلطة وغياب التنسيق بين مختلف الإدارات الحكومية إلى أداء كارثي على مستوى تفشّي الوباء وإدارة حملة التلقيح. وتسببت موجة العدوى الجديدة جراء انتشار السلالة المتحورة دلتا بوفاة 1,000 شخص، كمعدّل متوسط، أسبوعيًا. علاوةً على ذلك، أثارت مقاطع فيديو أظهرت سوء تجهيز المستشفيات وإرهاق الطاقم الطبي، مشاعر الغضب والاستياء في نفوس المواطنين التونسيين الذين يعتبرون أن طبقتهم السياسية فاسدة وأنانية وقصيرة النظر. وبحلول 26 تموز/يوليو، بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 18,600 حالة، ما دفع الرئيس إلى التدخل، فهو يرى نفسه الحَكَم في القضايا الدستورية وحامي الأمن القومي. وهو عمد، منذ انتخابه في العام 2019، إلى رفع الصوت ضدّ الفساد والمحسوبية، ما ساهم في تجريد الطبقة السياسية من شرعيتها.
ما المضاعفات على المستقبل؟
من المتوقّع أن يعيّن سعيّد رئيس وزراء جديدًا يتولّى تشكيل حكومة تكنوقراط لمعالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية في البلاد. أما أولويته الثانية فتتمثّل في صياغة خارطة طريق من شأنها حشد دعم المجتمع الدولي والرأي العام المحلي. إضافةً إلى ذلك، أعلن سعيّد عزمه إدخال إصلاحات على الدستور وتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي. وتهدف هذه الخطوات إلى وضع حدّ للالتباس الحاصل حول الصلاحيات وتحديد سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان على نحو واضح. وقد تشمل خطته أيضًا إجراء استفتاء بشأن النظام السياسي الجديد، وإصلاح قانون الانتخابات، وعقد انتخابات مبكرة.
في هذا الإطار، سيواجه سعيّد تحديًا يتمثّل في توفير الشرعية لخارطة الطريق التي رسمها. ويعني ذلك حشد دعم الطبقة السياسية والمؤسسات الوطنية، ولا سيما الرباعي المؤلّف من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات اليدوية، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لكن سعيّد يخاطر بجرّ بلاده نحو مرحلة من اللااستقرار السياسي المطوّل ما لم يعمد إلى تقديم تنازلات سياسية وإشراك القوى الاجتماعية والسياسية في مساعيه هذه.
وتتزامن هذه الأزمة الدستورية مع خوض تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي جديد. لذا، من الضروري وضع خطة عمل واضحة ومدعومة على نطاق واسع، من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما نظرًا إلى عبء الدين الذي يثقل كاهل تونس، والتمويل الضخم الذي تحتاجه. لذلك، ينبغي على تونس انتشال نفسها سريعًا من دوامة اللااستقرار هذه، واستعادة نظامها الديمقراطي، والتصدّي للتحديات الاقتصادية المُحدقة.
—————————-
لماذا لجأت “النهضة” للتهدئة مع قيس سعيد بعدما وصفت قراراته بـ”الانقلاب”؟ هذا ما تريده الحركة
عربي بوست
مساء 26 يوليو/تموز الجاري، وَجَّه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية (أكبر كتلة برلمانية)، رئيس البرلمان، دعوة إلى أنصاره لمغادرة موقع اعتصامهم أمام البرلمان، حيث كانوا يحتجون على “تدابير استثنائية” اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في اليوم التالي.
وبدا خيار “النهضة” (53 نائباً من 217) مختلفاً عن خيارات حركة الإخوان المسلمين في مصر، عقب الإطاحة في 3 يوليو/تموز 2013 بالرئيس آنذاك، محمد مرسي المنتمي للجماعة، بعد عام واحد له في الرئاسة.
كما بدا مختلفاً عن خيار الشعب التركي، الذي تصدى لمحاولة انقلابية فاشلة، في 15 يوليو/تموز 2016، عبر إلقاء أنفسهم أمام الدبابات والاعتصام في الشوارع، ما حمى الديمقراطية التركية من الانهيار.
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال تكريم عدد من الضباط في الجيش مؤخراً (صفحة الرئاسة التونسية)
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية في 25 يوليو الجاري، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحاً للمسار”.
وبحسب خبراء، توجد دوافع عديدة وراء خيار حركة “النهضة” بالتهدئة حتى الآن، في مواجهة التدابير التي يشدد سعيّد على أنها “ليست انقلاباً”، وأنه اتخذها لـ”إنقاذ الدولة”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
تجنب الاحتكام للشارع
وقال أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، مهدي مبروك، للأناضول، إن سلوك “النهضة” بالتهدئة “ناجم عن قراءة سريعة للأحداث وتطوراتها وانعكاساتها”.
وأضاف أن “تجنب التصعيد والاحتكام إلى الشارع يتم، لأن التصعيد سيخرج بالخلاف السياسي إلى مآلات منها توريط الجيش بالتدخل لوقف التحركات”.
وتابع: “الاحتكام إلى الشارع قد يولّد قوة اجتماعية جديدة مؤيدة للرئيس، أي إلى شرخ مجتمعي قد يؤدي إلى العنف ورأينا بدايات ذلك أمام البرلمان، رغم أن الأمن كان محايداً، رغم دعوات كثيرة من داخل خصوم النهضة من دوائر محيطة برئيس الجمهورية على أساس المحاسبة الآن، وهنا وخارج مجال دولة القانون”.
قيس سعيد الغنوشي
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي/ رويترز
ووفق مبروك، فإن “النهضة بهذا القرار الحكيم استطاعت أن تسحب البساط من كل دعاوى الضغائن، وأعادت الخلاف إلى المربع السياسي عوض مربع الشارع، وهي بذلك تسحب أي ذريعة للرئيس للذهاب إلى أقصى السيناريوهات الممكنة التي تنسف ليس الدستور فقط، بل تجربة الانتقال الديمقراطي على تعثرها”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
جبهة الرافضين
والأمر الثاني الذي يدفع “النهضة” إلى هذه الاختيارات، بحسب مبروك، هو أن “هذا يجعل الذين يختلفون مع قرارات سعيّد في صف واحد، هو صف الدفاع عن الدستور والانتقال الديمقراطي إذا لم تتصدر النهضة ذلك”.
وأردف: “رأينا موقف سناء بن عاشور (أستاذة قانون دستوري بالجامعة) ولفيف مهم من أساتذة القانون الدستوري، الذين اعتبروا ما قام به سعيّد خرقاً للدستور أو محاولة للسيطرة على السلطة، وقد استولى الرئيس على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بجعل الأوامر الترتيبية من مهامه، عوض أنها من مهام رئيس الحكومة”.
وأكد أن “هذا الأمر لا يجعل النهضة وكأنها هي الناطق الرسمي الوحيد باسم المحافظة على الشرعية، بل هي معركة اجتماعية تخوضها كل النخب”.
الأزمة السياسية في تونس
رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (مواقع التواصل الاجتماعي)
ورأى أنه “كلما انسحبت النهضة من قيادة هذه الجبهة (المناهضة لقرارات سعيّد) تعزز مخيم المدافعين عن الدستور والرافضين لإجراءات سعيّد الاستثنائية”.
واستطرد: “لذلك رأينا موقف حزب العمال (أقصى اليسار) وأطراف عديدة بقطع النظر عن اختلافهم الجذري مع النهضة، فهم يريدون إعادة ترتيب الأمور للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية خارج النزعات الشعبوية والنزعات الاستبدادية والدفاع عن مدنية الدولة، وهذا لا يكون بتصدر النهضة، بل بالظهور أنها فاعل من الفاعلين فقط”.
ورأى مبروك أن “تصدر النهضة واستحواذها الرمزي على هذه الجبهة سيفرغ الجبهة تماماً، وهذه الجبهة ستتوسع كلما ذهب الرئيس في إجراءات استثنائية جديدة”.
معركة دستورية
في الاتجاه ذاته، ذهب بولبابة سالم، محلل سياسي، بقوله للأناضول، إن “الرغبة موجودة (لدى النهضة) في تشريك الجميع في الدفاع عن الديمقراطية”.
وأضاف: “مؤكد أن هناك أحزاباً يسارية، مثل حزب العمال والتكتل والجمهوري وائتلاف الكرامة، ومنظمات وطنية، ترفض العودة إلى مربع الاستبداد، ويريدون التمسك بالدستور والشرعية”.
ورأى أن “النهضة لا تريد أن تظهر أن المعركة بين الغنوشي وسعيّد أو النهضة وسعيّد. تريد أن تكون المعركة دستورية يشارك فيها كل من يدافع عن الدستور”.
مآزق الرئيس مع حلفائه
واعتبر مبروك أن “الرئيس يواجه مآزق عديدة دستورية وقانونية واقتصادية اجتماعية حتى مع حلفائه”.
وتساءل: “كيف يمكن لحكومة الرئيس أن تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي مجبرة على اتخاذ قرارات يبدو أنها إجراءات ستعيد الخلاف الحاد بين الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) والرئاسة”.
ورأى سالم أنه “تمّ كبح جماح أي مسعى تسلطي بضغط خارجي قوي وبضغط داخلي أيضاً”.
وأوضح أنه “لم يكن هناك ترحيب من شخصيات وطنية معروفة بدفاعها ضد الاستبداد منذ عهد (الرئيسين الحبيب) بورقيبة (1957-1987) و(زين العابدين) بن علي (1987-2011)، ولا يمكن أن نقول إن هؤلاء يدافعون عن النهضة، بل هم يدافعون عن الديمقراطية”.
وتابع: “كذلك هناك ضغط خارجي، وخاصة بيان الاتحاد الأوروبي، وبالخصوص الولايات المتحدة الحريصة على دعم المسار الديمقراطي في تونس”.
وزاد بأنه “لأول مرّة أمريكا تصدر بلاغين (بيانين) حول بلد صغير مثل تونس، ووزير خارجيتها يهاتف الرئيس (سعيّد)، وهذا لا يتم مع الدول الصغرى”.
ورأى أن “هناك حرصاً من القوى الخارجية المؤثرة، لذلك الأمور تتجه نحو الانفراج على عكس ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي”.
مزاج الشارع ضد “النهضة”
ووفق سالم، فإن “ميل النهضة إلى التهدئة إلى حد الآن لا يُفسر فقط بالرغبة في تجنب التصعيد وتشريك كل القوى في الدفاع عن الدستور ومسار الانتقال الديمقراطي المهدد بالقرارات الرئاسية الأخيرة”.
واستطرد: “النهضة تعرف أن قسماً كبيراً من الشارع ليس معها والدفع بأنصارها إلى الشارع لن يجد أي استجابة، خاصة أمام تنامي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الصحية”.
وأردف: “هناك أصوات داخل النهضة تعرف أن مزاج الشارع التونسي ليس معها”.
وزاد بأن “المزاج الشعبي ليس في صالحها، والقرارات الأخيرة للحكومة (في المجال الصحي) جعلت النهضة تتحمل أوزار الحكم وهي لا تحكم، لكن عليها تحمل المسؤولية في النهاية، بالإضافة إلى البروباغندا (الدعاية) الإعلامية التي تعمل ضدها”.
واتفق سالم ومبروك في اعتقادهما بأن الشارع فقد الثقة في “النهضة” بعد سنوات المشاركة في الحكم والضعف الداخلي.
“نمر من ورق”
اعتبر مبروك أن “النهضة نمر من ورق وفزاعة عاش على وقعها الرأي العام بينما ليس لها فكر استراتيجي قادر على التوقع والتقاط الذبذبات في الأيام الأخيرة حول أزمة صحة المواطن وتنامي حركات احتجاجية في الأحياء الشعبية والمجال الريفي”.
والعامل الثاني في ضعف “النهضة”، وفق مبروك، هو غياب الفطنة السياسية حيث تمثل في “إثارة قضية جبر الضرر (لمتضرري انتهاكات نظام زين العابدين بن علي ومنهم نهضويون)، على نبلها، في ظرف الوباء (كورونا)، مما جعل الرأي العام الشعبي يرى أن النهضة أنانية وتفكر فقط في مصلحتها”.
وتابع: “وهذا أدى إلى ردة فعل شعبية من السابق لأوانه معرفة من حشدها ومن يقف وراءها وكيف تتم تغذيتها”.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية أطرافاَ داخلية ودولاً عربية (لم تسمها)، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
ورأى مبروك أن “النهضة لن تستطيع الدفاع عن فكرة أن هذا انقلاب، وهي تعرف أن عليها نوعاً من عدم القبول الشعبي، ولذلك ربما حتى قواعدها شُلت على المستوى النفسي والعصبي، ولم تستطع رد الفعل”.
واستطرد: “يبدو أن عدم حضور النهضويين إلى مقر الحزب وإلى البرلمان، رغم دعوات الرئيس (الغنوشي) هو مقياس لغضب داخلي في النهضة.. هناك من يقول إن النهضويين حمّلوا الرئيس خياراته في التحالف مع نبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس- 29 نائباً)”.
وخلص إلى أنه “ربما هذا ما دفع النهضة إلى إعادة قراءة موازين القوى في الشارع، وبالتالي ركنت إلى الحلول السلمية السياسية (…) ومراجعة القرارات الاستثنائية واعتبارها انقلاباً، ولكن سيُواجه داخل الدستور”.
اتجاه نحو التهدئة
توقع سالم الاتجاه نحو الانفراج بالقول: “ليس وارداً الدخول في مناكفات سياسية، فالنهضة تتجنب المواجهة حتى تظهر أنها حزب يريد حل المشاكل بطريقة سلمية مدنية”.
وأضاف: “نبرة خطاب الرئيس (سعيّد) الحالية تراجعت عن 25 يوليو، ويبدو أنه تراجع في مسألة النيابة العمومية التي أعلن أنه سيكون رئيسها وهي ستعود إلى القضاء، خاصة بعد بيان المجلس الأعلى للقضاء (مستقل) المشدّد على استقلالية القضاء”.
وتابع أن “الرئيس صرح بأنه ليس انقلابياً، بل هو مع الحرية وليس مستبداً”.
التهدئة ليست نهائية
وبشأن التهدئة الراهنة من جانب “النهضة”، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، إن “هذا ليس أمراً نهائياً.. إذا تطور الوضع يمكن أن تدعو النهضة إلى مسيرات كبرى”.
وأضاف الشعيبي للأناضول أن “النهضة التجأت إلى أسلوبها التقليدي في التعامل مع الأزمات السياسية لدعوة كل الفرقاء للجلوس على طاولة واحدة للحوار”.
وتابع: “اعتبرنا أن الأزمة يمكن حلّها بالحوار، لأن إجراءات الرئيس أحدثت كسراً اجتماعياً حاداً، والنهضة لا تغرب في المغامرة بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع”.
وأردف: “ليس هناك استثناء مطلق للنزول إلى الشارع، الذي له مناسباته وليس رد فعل آلي”.
وأوضح: “في البداية نزلنا إلى الشارع للاحتجاج على إجراءات اخترق بها الرئيس الدستور، ولكن أمام التراجعات المتتالية للرئيس تفاعلت النهضة بإيجابية، ومازالت تنتظر وتراقب تطور الأوضاع لتشكيل موقفها النهائي من الأوضاع”.
———————-
======================
تحديث 30 تموز 2021
—————————–
العرض التونسي للمشاهد السوري/ راتب شعبو
من الواضح أن جزءًا مهمًا من الشارع التونسي، وهو جزء بارز ونشيط في الشارع التونسي اليوم، يتعامل مع الرئيس قيس سعيد على أنه من خارج النظام، فيرى أن القمع الذي تعرضت له التظاهرات السلمية المناهضة للحكومة وما شهدته من اعتقالات وانتهاك للحريات، وأن التردي الصحي (أزمة كورونا التي كانت الأسوأ بين الدول الأفريقية) والاقتصادي (أزمة المديونية فقد بلغ حجم الدين 100% من الدخل الوطني)، هو من مسؤولية البرلمان والحكومة من دون الرئيس، وأنه لو كان الأمر للرئيس لما عانت تونس هذا الذي تعانيه. ينبع هذا الاعتبار الشعبي من أن الرئيس بلا حزب، بل مضاد للأحزاب التي يزداد النفور الشعبي منها، ليس في تونس فحسب، بل في مجمل البلدان العربية التي تشهد حراكات شعبية. وهذا يطرح مشكلة فعلية على المضيّ في مسار ديمقراطي.
من المفهوم أن يعاني البلد، في مرحلة تكريس الديمقراطية بعد استبداد مديد، أزماتٍ عدة أهمّها ما يتعلق بالاقتصاد من جراء حذر رؤوس الأموال في مراحل الانتقال، وعداء أرباب العمل الناشئين في بيئة استبداد والمتطبعين بآليات العمل في نظام الاستبداد، هذا فضلًا عن الضغوط الخارجية الممكنة. ومن المفهوم أن يعاني البلد حالة بروز صراعات حزبية كانت مكبوتة، واضطرابات وتعبيرات شعبية كانت مقموعة… إلخ. ومن المرجّح أن يؤدي مثل هذا الحال إلى نفور الناس ويأسهم، بعد أن منّوا أنفسهم بآمال عريضة، ومن ثم أن يميلوا إلى نظام أكثر صرامة. يمكن أن يميل الناس، تحت ضغط التدهور الاقتصادي والتعب من الصراعات الحزبية وعمليات التعطيل غير المعهودة، إلى التخلي عن حرياتهم التي ثاروا وضحّوا لأجلها، لصالح “حكم قوي”. هذا منشأ النكوص الاستبدادي الشائع، الذي شهدناه في مصر، ثم ندم عليه المصريون، ونشهد بوادره في تونس اليوم. في كلتا الحالتين، كان النكوص مشفوعًا بتأييد شعبي مهمّ.
مشكلة تونس اليوم أن أقوى طرفين فيها يشكلان خطرًا على الديمقراطية الفتية. الأول هو الرئيس الذي يعادي الأحزاب لصالح ديمقراطية “المجالس البلدية”، في حين أن الأحزاب من العناصر الأساسية في النظام الديمقراطي، ولا يوجد تعارض بين المجالس المحلية والأحزاب السياسية. الثاني هو حزب النهضة الذي لا تتوافق مرجعيته الإسلامية مع الديمقراطية في النهاية، لأنه يتطلع إلى بناء مجتمع على صورة مسبقة تستبعد الشركاء، فتبدو له الديمقراطية مرحلة مفروضة يسعى، في عمق برنامجه الإسلامي، إلى نسفها. كلا الطرفين خطر على بناء قواعد ديمقراطية، ومن أهمها خلق قدر من الثقة لدى الشعب بالأحزاب وبالطبقة السياسية.
التشظي الكبير في تركيبة البرلمان التونسي المنتخب في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشير إلى فقر دم حزبي في البلاد، على كثرة الأحزاب، وإلى قلّة اعتبار الناس للأحزاب، حتى الحزب الإسلامي العريق (حركة النهضة) الذي يشكل أكبر كتلة برلمانية، ولكنها كتلة صغيرة مع ذلك (52 نائبًا من أصل 217). ضعف كتلة النهضة البرلمانية، إضافة إلى التراجع الكبير في شعبية الإسلاميين عمومًا، عقب محاولاتهم ركوب موجة الثورات الديمقراطية العربية، بدلًا من الاندماج فيها، جعل حركة النهضة في تونس ضعيفة أمام “انقلاب” الرئيس، وعاجزة عن حشد رفض شعبي ينتصر لرئيسها الذي منعه الجيش من دخول مبنى البرلمان، والذي ناشد الناس النزول إلى الشارع لإحباط الانقلاب، على الطريقة التركية، كما قال، ولكن من دون جدوى.
لا يمكن لقيس سعيد أن يكون عبد الفتاح السيسي؛ لأنه من خارج مؤسسة الجيش أولًا، ولأنه بلا تنظيم سياسي يسانده ثانيًا، والأهم لأنه ليس ابنًا شرعيًا للنظام القديم، فيمكن لقوى النظام القديم الذي لم يرحل، الاطمئنان إليه. في أحسن حال، يمكنه أن يكون سعيد واجهة لحكم عسكري، ولكن لا يبدو أن للجيش التونسي شهية للحكم، كما حال نظيره المصري. على هذا؛ لا يستطيع الرجل أن يكون “الرجل القوي” الذي قد يريده الجزء من الشارع التونسي الناقم على تركيبة الحكم الجديد وعلى الصراعات العبثية في البرلمان، في ظل التدهور الاقتصادي والصحي.
انقلاب الرئيس، أو “الدكتاتورية الدستورية”، كما يسمّيها، لا يملك أن يحسّن من الحال الاقتصادي للبلد، وهذا، إضافة إلى النقمة السياسية التي سببها الانقلاب الذي من المرجح أن يزيد من حال التوتر في البلاد، سيثبت في ذهن العامة حقيقة أن الأفراد، مهما كانوا نزيهين ونظيفي اليد، لا يمكنهم حل المشكلات المعقدة لبلدٍ عانى طويلًا الاستبداد وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية. وأن العمل السياسي المنظم، والتنافس الحزبي، جزء لا غنى عنه في الآليات الديمقراطية التي لا يناضل الناس من أجلها إلا لأنها أفضل وسيلة حكم لتحصيل حقوقهم والحفاظ عليها، فيما يقوم الرئيس التونسي بتعليق الديمقراطية لتحصيل حقوق الناس، مستخدمًا لغة خطابية خاوية “فلوس الشعب تعود للشعب”، و”نحن دولة لا نتسوّل” … إلخ. هذا مسار يفضي في النهاية إلى عكس ما يراد له.
من جهة أخرى، على الرغم من اعتدال حركة النهضة وسعيها المتماشي مع المعايير الديمقراطية، من الواضح أنها تشكل مصدر قلق في الحقل السياسي التونسي، وفي الشارع أيضًا. قسم مهمّ من اليسار التونسي، ومن المنظمات الحقوقية، “تفهّم” الانقلاب، واكتفى بالتحذيرات والمطالبة بضمانات، كما جاء مثلًا في بيان المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، وبيان الجمعية التونسية للقانون الدستوري. يمكن القول إن هذه مشكلة يسارية في منطقتنا. الاعتقاد بأن الإجراءات القسرية هي الطريقة الفعالة ضد التنظيمات الإسلامية، اعتقاد خاطئ، لا يقود إلا إلى توفير بيئة مناسبة تتغذى عليها ميول الإسلام السياسي، حتى أكثر اتجاهاته تطرفًا.
الخروج من الدائرة المفرغة، التي تبدأ بسيطرة الجيش وتنتهي بسيطرة الإسلام السياسي، إنما يكون عبر الخلاص من خللين: الأول هو الكفر بالأحزاب والبحث عن خلاص عام عبر أفراد، كما كان حال التونسيين مع قيس سعيد؛ والثاني هو إيمان الإسلاميين أو تسليمهم بأنهم يحملون في رؤوسهم “خلاص الأمة” بالخلاص من الآخرين، فينظرون إلى الديمقراطية على أنها شرّ لا بدّ أن يتمكنوا في كنفه كي يقتلوه، وهذا ما لا يخفى على خصومهم، وما يثير القلق والنفور الدائم منهم.
لا ريب في أن أصداء العرض التونسي تتردد في الأرجاء السورية، وعلى الرغم من الفروق الكثيرة، يمكن الاستفادة منه، بوصفه تجربة متقدمة.
مركز حرمون
——————————–
انقلاب قيس سعيّد على نفسه/ بشير البكر
لم يكمل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عامين من ولاية رئاسية بدأها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدوم خمسة أعوام قابلة للتجديد. وبالتالي هناك متسع من الوقت لمفاجآتٍ أخرى، ولن يكون انقلاب الخامس والعشرين من يوليو/تموز الحالي السابقة الأولى والأخيرة للرئيس، الذي كان أسلوبه في الحكم حتى أيام من الانقلاب مثار تندّر، وإذ به يكشف عن وجه نسيه الشعب التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن المشهد في بداية النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، عندما أزاحه رئيس وزرائه الجنرال زين العابدين بن علي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 في انقلابٍ أبيض، تم إدراجه تحت بند الأسباب الصحية. ومن تلك الأسباب أن بورقيبة، الذي بلغ سن الرابعة والثمانين بعد ثلاثين عاما متواصلة في الحكم، بدأ يتّخذ قراراتٍ مرتجلة يتراجع عن بعضها في اليوم الثاني، ومنها تسمية وزراء ومدراء مؤسسات ذات صفة إستراتيجية. ولو لم يتجرّأ بن علي على بورقيبة لما كان أحد يقدر على إزاحته من كرسي الرئاسة، فهو “المجاهد الأكبر وباني تونس الحديثة” حسب البروتوكول الرسمي، وكان سيظل في مكانه حتى وفاته في عام 2000.
في أول خطابٍ له بعد الانقلاب، ظهر قيس سعيّد في واحدةٍ من هيئات بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه، وتتمثل في استقبال وزراء ومسؤولين في مكتبه بقصر قرطاج، وتوجيههم بصورة مباشرة، بينما تسجل كاميرا التلفزيون الرسمي المشهد الذي يصبح الخبر الأول في نشرة المساء التي تدوم قرابة ساعة. وأكثر نقطةٍ توقف عندها سعيّد أن “المؤسسة النيابية قامت بالسب والشتم على رئيس الدولة”. وهذا أمرٌ مدانٌ لو حصل فعلا، لأن شتم مقام الرئاسة يعني شتم البلد، ولكنه لا يشكل سببا مقنعا لتجميد عمل البرلمان شهرا، وربما الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة لمداواة كبرياء رئيس الدولة الجريحة. وقدّم الرئيس عرضا غير مقنع للدفاع عن نفسه، واستعمال صلاحياته الدستورية، ومنها الفصل 80، وظهر أنه يفسّر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته. وهناك قراراتٌ على درجة كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة، منها فرض حظر تجوّل شهرا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، في وقتٍ تعاني البلاد من أزمة اقتصادية.
يبدو أن سعيّد مصابٌ بداء الزعيم بورقيبة شخصيا، وهو مرضٌ صعبٌ وخطير، وسبقه كثيرون من رجالات السياسة في تونس إلى تقمّص المجاهد الأكبر، ولكنهم فشلوا، لأن بورقيبة ابن زمنه، ووصل إلى المكانة التي حازها بسبب توفر ظروف محلية ودولية لا تتكرّر. ويظهر أن سعيّد لم يقرأ بورقيبة جيدا، ولذلك لم يذهب إلى صناديق الاقتراع ليدلي بصوته في أي انتخاباتٍ رئاسيةٍ حصلت بعد سقوط نظام بن علي. وكلما يمر الوقت على الانقلاب، يتبين أنه مرتجل، فالأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني انحازت للديمقراطية، ولذلك طالبت الرئيس بضماناتٍ ملزمةٍ وملموسةٍ في ما يتعلق باحترام الدستور، وتقديم خريطة طريق للخروج من الأزمة. أميركا وأوروبا وضعا سعيّد أمام امتحان “استئناف النشاط البرلماني بأسرع وقت.. وتشجيع الفاعلين السياسيين في تونس على الامتثال للدستور، واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجة الأميركية. أما الأوساط المالية فكان رد فعلها من خلال تراجع قيمة السندات السيادية. هذه إشاراتٌ صريحةٌ إلى أن انقلاب سعيّد لن يجد تغطيةً محليةً أو دولية. وبالتالي، فإن الخطوة التي خطاها مشروطٌ نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع ذي نفع عام للبلد، وليس لصناعة ديكتاتور جديد. وإذا ما استمرّت ردود الفعل على هذا المنوال، لن يتأخر الوقت، حتى يتبين أن أكبر إنجاز حققه الرئيس سعيّد هو الانقلاب على نفسه.
العربي الجديد
——————————-
سذاجة اعتذاريي الانقلاب في تونس/ أسامة أبو ارشيد
ما يجري في تونس انقلاب مكتمل الأركان، حتى الآن. ولا يخالف هذا تكييفه أنه مسعى إلى التأسيس لـ”ديكتاتورية دستورية”، كما كانت أشارت وثيقة رئاسية سرّية تمَّ تسريبها في مايو/ أيار الماضي، فالتعدّي على الدستور والاستحواذ على الحكم، سواء بالقوة أم بالخداع والمراوغة، أمران يدخلان في تعريف الانقلاب. ولا ينبغي التوهم أننا أمام نزاع صلاحياتٍ بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، ولا حتى أمام خلافٍ بشأن طبيعة النظام السياسي التونسي الذي يريده الرئيس قيس سعيّد رئاسياً، في حين أنه في الأصل برلمانيٌّ، انتهى به الأمر مختلطاً. القضية أعمق من ذلك وأخطر. ما يجري هو استكمال لحلقات وأد روح التغيير والديمقراطية في المنطقة العربية، وهو يأتي في سياق إقليميٍ تُهَنْدِسُهُ دول عربية تتزعم معسكر الثورات المضادّة.
هذه هي الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن تكييفنا المشهد التونسي الراهن، وأي انجرار إلى التبريرات التي يقدّمها التيار الداعم للانقلاب، مثل عدم كفاءة عمل مؤسستيِّ البرلمان والحكومة، وتدهور الأوضاع الشعبية المعيشية، وتصاعد الإصابات بفيروس كورونا، تغدو وقوعاً في شرك التشتيت الذي نصبه هؤلاء. وللأسف، فينا كثيرون ممن لا يتردّدون، سفهاً وجهالة، في أن يكونوا اعتذاريين عن الطغاة والمستبدّين والتسويغ لهم. أيضاً، أي تساوق مع المزاعم التي تحاول تصوير الأمر على أنه صراع علماني – إسلامي، أو اختزال الأمر في أخطاء التيارات الإسلامية، تكتيكياً واستراتيجياً، في سيرورة عملها السياسي، والحديث هنا عن حركة النهضة تحديداً، يغدو نوعاً من الإسفاف والتواطؤ، بل وخوضاً لمعركةٍ ضد عدو مُتَخَيَّل يريد معسكر الثورات المضادة أن يجعله موضوع التناطح، في حين يخنق هو ما تبقى من روحية تتوق إلى التغيير الديمقراطي عربياً.
لا أريد أن أسترسل كثيراً في تفاصيل الانقلاب ومقدماته وحيثياته وحيله، ولا في مزاعم سعيّد عن خطورة الأوضاع واضطراره إلى التدخل لإنقاذ البلاد، ولا حتى عن كذب استناده إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، فقد قيل وكتب الكثير في ذلك، وتمَّ تفنيده. الحقيقة هنا واحدة، ما فعله سعيّد هو سطو على السلطة، بدعم من دول عربية، وتحديداً من الإمارات ومصر والسعودية. لم يكن سعيّد، منذ توليه الرئاسة عام 2019، طرفاً محايداً في النزاع والشقاق السياسي الذي تعاني منه تونس، وجعل منه أحد مبرّرات انقلابه. هو خصم منذ اليوم الأول. لم يكن حكماً بين السلطات، مترفّعاً عن التجاذبات السياسية والحزبية، بل كان مسعّراً لنيرانها، صابّاً الزيت على ألسنة لهبها، وعنصراً مخرّباً لإيجاد أي توافقات وطنية، ومعطّلاً لتعزيز الضمانات الدستورية لتحقيق استقرار سياسي.
ما لا يفهمه بعض السطحيين الذي خرجوا يحتفلون بانقلاب سعيّد، ظانّين أنه يمكن أن يكون المنقذ المنتظر، أن الرجل لا يملك مشروعاً سياسياً، ولا رؤية، ولا برنامجاً. هو سياسي شعبوي بامتياز، لا يقل سوءاً عن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. حكم الأخير دولة عظيمة، من حيث الإمكانات ورسوخ المؤسسات والقوة. ومع ذلك كاد أن يودي بها. صحيحٌ أن “المؤسسة الحاكمة” تمكّنت في المحصلة من لجم نزواته وجموحه المنفلت، ولكن ذلك لم يمنع خدوشاً حادّة ألحقها بالديمقراطية الأميركية، وانقساما مجتمعياً عَمَّقَهُ، وأضراراً كارثية، اقتصادياً وصحياً واستراتيجياً، ترتّبت على سنوات رئاسته الأربع. وبعد قرابة ثمانية أشهر من نهاية رئاسته، ما زالت الولايات المتحدة تترنّح منها، وما زال التوتر المجتمعي والحزبي يتصاعد ويتسع، إلى درجة أن تصبح المطاعيم ضد كورونا وارتداء الكمّامات الطبية عنواناً للهوية الحزبية والسياسية والإيديولوجية. أما ثالثة الأثافي، فهي بقاء سطوته على الحزب الجمهوري وعلى عشرات الملايين من الأميركيين، بمعنى أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد نهاية الحقبة الترامبية، هذا إذا كانت ستنتهي فعلاً.
هذا حال الدولة الأعظم، ذات المنظومة القيمية والديمقراطية والمؤسّساتية الراسخة، فكيف سيكون حال تونس تحت رئيس شعبوي، نجح فيما فشل فيه ترامب، منصّباً نفسه مصدراً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع أنه لا يملك خبرةً في الحكم، ولا يملك رؤية ولا ومشروعاً، ولا حتى برنامجاً لإدارة الدولة وتسيير شؤونها؟ المفارقة هنا أن بعض السذّج، تونسياً وعربياً، ممن يتعاطفون مع الخطاب الخشبيِّ المُتَكَلَّفِ المُتَقَعِّرِ للرجل، يعجزون عن استيعاب أنه ليست الديمقراطية التونسية وحدها التي فشلت في التصدّي لكثير من أزمات مجتمعها ومعضلاته وطموحاته، بل إنك لا تكاد تجد دولةً عربيةً واحدة ناجحة. وإذا كان هذا هو الحال، فلماذا لا يكون الجواب انقلاباً على كل تجربة فاشلة، كما في مصر مثلاً، التي وقع فيها انقلاب عسكري دموي، ومع ذلك هي دولة فاشلة اليوم؟ إذن، المسألة ليست مرتبطةً بنجاح تجربةٍ أو فشلها، بقدر ما أنها مرتبطة بنظام الحكم فيها، ديمقراطيًا كان أم دكتاتوريًا، فإذا كانت تتوسّل الأولى فلا مناص من وأدها، وذلك حفاظاً على زيف “الاستثناء العربي” المتنافر، حسب زعمهم، مع الطبيعة والثقافة العربيتين.
لا شك أن التجربة الديمقراطية التونسية في مهدها عانت من العوار، وهذا مفهوم، فللأسف لا يوجد تراث خبراتي يُبنى عليه، ولا يوجد سياق عربي يستفاد منه. هذا لا ينفي أخطاء، بل وخطايا، ارتكبها فاعلون كثيرون في فضاء التجربة التونسية. ولكن حصر كل الرزايا والعثرات بهم تعسّف في الحكم، وقد يكون داخلاً في سياق التواطؤ. ثمَّة من لم يتوقف عن التآمر، داخلياً وخارجياً، على ثورة الياسمين، مهد الثورات العربية منذ أكثر من عقد. كانت ثمَّة هَنْدَسَة للفوضى في البلاد، بما في ذلك تمكين مهرجين وتسويقهم في البرلمان، من مخلفات نظام زين العابدين بن علي، لتكره الناس بالديمقراطية. وعلى الرغم من أن حركة النهضة، وهي الحزب الأول في عدد المقاعد في البرلمان الحالي، لم يعط فرصة تشكيل الحكومة، ودخل في مساومات وتوافقات كثيرة مع قوى حزبية علمانية أخرى، من خلفياتٍ شتى، إلا أن هناك من يصرّ على تصوير الأمر وكأنه صراع إسلامي – علماني، وعلى أنه فشلٌ جديد في الحكم لما يوصف بـ”الإسلام السياسي”.
ليس الإسلاميون وحدهم هم من يرفضون انقلاب سعيّد، بل الغالبية، وإن لم يكن ذلك بالوضوح المطلوب، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون والخبراء الدستوريون وقضاة كثيرون، إلا من بعض مرتزقة معسكر الثورات المضادة. ومع ذلك، سارع إسلاميون كثيرون مهووسون بجلد الذات إلى تحميل “النهضة” المسؤولية الحصرية عن الانقلاب. لا شك أن “النهضة” تتحمّل جزءاً كبيراً من الفشل، ولكن المنظومة السياسية والحزبية التي أنتجتها الثورة شريكة في ذلك أيضاً. ولا تملك إلا أن تقف مشدوهاً أمام بعض الإسلاميين الذين كانوا يتغنون بالأمس بـ”حكمة” النهضة ومرونتها في التعامل مع “الدولة العميقة” في تونس، وجنوحها نحو السلم معها، وبناء التوافقات مع خصومها السياسيين والإيديولوجيين، مقارنةً بتجربة الإخوان المسلمين في مصر، وهم يقرّعونها اليوم ويعتبرونها مسؤولة عن كل ما يجري بذريعة تهاونها في الحسم! إنهم التيار نفسه الذي يتغنّى بقوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزمه، وحركة حماس في قطاع غزة، من دون أن يدركوا اختلاف السياقات وحيثيات كل تجربة، وإذا ما فشلت واحدةٌ من هاتين التجربتين سيكون مصيرُهما الجلد، أيضاً، من هؤلاء.
باختصار، ما يجري في تونس ليس خلافاً على تفسير الدستور، وانقلاباً على أسس التوازن المفترض بين السلطات فقط، وهو قطعاً ليس محاولةً لإنقاذ البلاد من فشل آليات الحكم القائمة، ولا حتى لسحق الإسلاميين فحسب، بل إنه يندرج في سياق إجهاض أحلام العرب بالديمقراطية والحرية والكرامة والمواطنة والإنسانية. للأسف، نجح معسكر الثورات المضادّة في النفاذ إلى مهد الثورات العربية وأملها في تجربة ديمقراطية ناجحة، مستغلاً بعض هفواتها وهناتها وأخطائها، ومستعيناً برئيسٍ مسكونٍ بنرجسيةٍ لا مقوّمات لها، أخذ تونس رهينة، وعطّل مسار تقدمها، فانتهى الأمر إلى ردّة ديمقراطية جديدة. هل هذا يعني أن الستار قد أسدل على المشهد؟ ليس بالضرورة، فمع أن موقف المؤسّستين، العسكرية والأمنية، يبدو متساوقاً مع هذه الردّة، والموقف الغربي غامض، وموقف الأحزاب والقوى السياسية التونسية ضعيف، وموقف القوى النقابية والمدنية كمن يمسك العصا من المنتصف، والموقف الشعبي مرتبك، إلا أنه لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه الأوضاع، مع ضرورة الاعتراف بأن سعيّد يبدو في وضع أقوى من معارضيه.
العربي الجديد
—————————-
أي سيناريوهات تنتظر تونس؟/ محمد أحمد القابسي
في الوقت الذي يستمرّ فيه الجدل في تونس بشأن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتفعيله الفصل 80 من دستور 2014، وأمام استمرار تدفق سيل القراءات السياسية والقانونية، والتي اعتبر أغلب أصحابها من فقهاء القانون الدستوري، ومن فاعلين سياسيين وحقوقيين ومتابعين للشأن العام، أن ما قام به سعيد انقلاب على الدستور، ونسف لمسار كامل، حسب قراءة متعسّفة وشخصية لفصوله القانونية، فيما اعتبر آخرون، ولأسباب مختلفة، هذا الإجراء الخطير محاولة من الرئيس لتصحيح مسار متعثر عاشت على وقعه منظومة هزيلة منذ الثورة في العام 2011.
وبقطع النظر عن دستورية أو عدم دستورية ما اتخذه سعيد من قرارات في ساعة متأخرة من يوم الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري (ذكرى عيد الجمهورية)، تعلقت أساسا بتجميد عمل البرلمان ثلاثين يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن كل النواب، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، علاوة على تدابير استثنائية شملت إعفاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرطاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى جانب تكليف الكتّاب العامين لهذه الوزارات أو مديري المصالح الإدارية بتولي تسيير شؤونها، بقطع النظر عن ذلك كله، فالثابت أن تونس، بعد هذا التاريخ، لن تكون كما كانت قبله، فالحركة التي أقدم عليها سعيّد لا تتمثل فقط في ما ذكر، بل هي سعي محموم وواضح إلى تغيير كلي وجذري للمنظومة السياسية برمتها، دستوريا وقانونيا وواقعيا، يمكن اختصارها في عنوان واحد، أن سعيد أصبح الآن هو الدولة والمنظومة، وأن تونس ستدخل، على مدى ثلاثين يوما، أفقا مجهولا غير مسبوق، عنوانه الأبرز إنهاء منظومة والإتيان بأخرى مجهولة الملامح والهوية، وقد تكون طريقا معبّدة للعودة إلى الحكم الفردي والاستبداد الذي ثار عليه التونسيون. ولذلك طالبت القوى الحية، ومجمل النخب في البلاد، سعيّد بضماناتٍ قويةٍ وواضحة، حتى لا يتحول تأويله المتعسف للفصل 80 من الدستور إلى سيف مسلط على رقاب التونسيين، يحدّ من حرياتهم العامة والخاصة، ولا سيما من حرية التعبير والصحافة والتظاهر… يضع فيه الرئيس يده على القضاء، حتى لو كان ذلك تحت شعار مكافحة الفساد، معيدا زمن الزعيم الملهم والرئيس المنقذ أو المستبد العادل الذي لن يعود إليه التونسيون إطلاقا. ما هي السيناريوهات التي تنتظرها البلاد في ظل هذه التحوّلات والمفاجآت؟
من الطبيعي أن تكون مقدّمات هذه السيناريوهات إسراع الرئيس فورا بوضع خريطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، تتضمّن روزنامة محدّدة تضبط آجال انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها، والعودة سريعا إلى نسق المسار الديمقراطي في البلاد. ورشحت معطياتٌ من اللقاءات التي جمعته برؤساء المنظمات الوطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والاتحاد الوطني للمرأة، أنها تشدّد على هذه الضمانات، وتعتبرها شرطا أساسيا لموافقة سعيد في ما أقدم عليه. وتقول هذه المعطيات إن دولا صديقة، مثل قطر وألمانيا وتركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي (الشريك الأول لتونس)، ذهبت في هذا الاتجاه، علاوة على مجمل الأحزاب التي نبهت، من خلال مواقفها، إلى خطورة الالتفاف على المسار الديمقراطي. ويُخشى من أن سعيّد قد قيّد نفسه بأجل شهر وحيد لتنفيذ التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها، والواردة في الفصل 80 من الدستور، وهي مدة قصيرة جدا. وقد لا تكفي لتمرير قراراتٍ وإجراءاتٍ تهم مصير البلاد، إذ تتطلب حيزا زمنيا واسعا للمصادقة عليها وتنفيذها، خصوصا إن كانت ذات طابع تشريعي أو ترتيبي يهم تصحيح مسارات إدارية وقانونية وسياسية، وهي معرّضة للطعن في أي وقت، ان لم تكن تتمتع بنسبة عالية من الشرعية الدستورية والقانونية. إذ يبدو أن سعيّد، بعدما أقدم على ما أقدم عليه، أصبح متخوّفا من المجال الزمني الذي حدّده لنفسه، والذي قد يفقده، في صورة عدم تنفيذ وعوده، مناصريه والمؤمنين بالديمقراطية وحلفاء تونس في الخارج ومنظومة العلاقات الثنائية والدبلوماسية.
ومهما يكن من أمر، وفي ظل الثلاثين يوما، فإن قيس سعيّد وجد نفسه أمام ثلاثة سيناريوهات صعبة، أولها دعوة ممثلين عن الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى الاتفاق سريعا على الخطوط الكبرى لتجاوز الأزمة، مع التزام علني بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية والانتخابية، وإن ما قام به ليس انقلابا على الدستور أو المسار الديمقراطي. كان ذلك المطلب الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، والذي طالب كذلك سعيّد في بيان أصدره، بعد اجتماع أمينه العام نور الدين الطبوبي بسعيّد، بضماناتٍ أخرى، أهمها ضمان حرية التعبير ومراجعة مسألة رئاسة النيابة العمومية والتمسّك بالدستور في أي إجراء يتخذه الرئيس، والنأي بالبلاد عن العنف والفوضى، مع الحدّ من الاجتهادات المفرطة في تأويل الدستور في ما سيتخذه الرئيس من مراسيم وتدابير وإجراءات، والعودة فورا إلى السير العادي لمؤسسات الدولة، بما يضمن استمرار المرفق العمومي لكل التونسيين.
ومن غير المستبعد في هذا السياق أن تصدر عن رئاسة الجمهورية، من ساعة إلى أخرى، روزنامة قصيرة في الأجل تضبط خريطة طريق الثلاثين يوما، وبيانات تحدّد خيارات النظام السياسي الذي ستعرفه تونس خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وخصوصا مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي، وفكرة الاستفتاء الشعبي لتنقيح الدستور وإجراء انتخاباتٍ سابقة لأوانها، والتحوّل إلى نظام برلماني صريح أو رئاسي صريح.
أما الخطوة التي ينتظرها الجميع، وتشكل مضمون السيناريو الثاني، فتتمثل في تعيين رئيس حكومة يبادر إلى تشكيل حكومة جديدة بصيغة مدنية، تبادر فورا بمباشرة مهامها، في ظل ما تشهده البلاد من تحدّيات قاسية، ممثلة في شحّ المالية العمومية وتردّي الخدمات وتزايد ضحايا جائحة كورونا، خصوصا وقد توفرت اللقاحات وأصبح مخزون الأوكسيجين مُرضيا، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، المشهود له بالقدرات القيادية والاستقلالية السياسية، بإدارة الملف الصحي.
أما السيناريو الثالث فيخشى فيه أن يمضي سعيّد في تنفيذ قرارات استثنائية فردية، قد لا تروق ولا تتوافق مع الضمانات التي قدّمها للمنظمات والدول والأحزاب، محتكرا السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو أسوأ السيناريوهات الذي قد يعجّل بانتحار سعيد سياسيا، والدخول بالبلاد في أتون المجهول. إذ لا أحد يعلم مدى التزام الرجل بتجميد عمل البرلمان للفترة المحددة بشهر، أم سيتواصل هذا التجميد، وخصوصا أن الفصل 80 (في الدستور) الذي اعتمده سعيّد في ما أقدم عليه يشترط أن يظل البرلمان في حالة انعقاد، وأن يستشير رئيس الجمهورية قبل تفعيل هذا الفصل رئيسي الحكومة والبرلمان، وذلك ما نفاه راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب. ويجمع متابعون للشأن السياسي، وللوضع الذي تردّت فيه تونس، على أن هذه الفرضية تظل ممكنة في غياب المحكمة الدستورية.
وفي غضون عدم وضوح ما يصدر عن الرئيس، تقول جهات موثوقة إن سعيّد سيُقبل، من يوم إلى آخر، على اتخاذ قراراتٍ عديدة، من شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع وتشبيك مسارات صعوبة الخروج من الأزمة، تهم خصوصا تعليق المجالس البلدية أو حلها، وإقالة عدد كبير من المحافظين، ومنع سفر رجال أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين رفيعين في وزارة العدل خصوصا. كما قد يبادر بتسمية مسؤولين جدد لكبرى المؤسسات العمومية، وإصدار مراسيم تشريعية عاجلة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولا يستبعد كذلك إيقاف متورّطين في قضايا فساد وإرهاب، بينهم نواب وسياسيون.
وفي ظل تواتر الأحداث وتسارعها، قد تقبل تونس على سيناريوهات أخرى أكثر تعقيدا وخطورة، بما يمكن أن ينسف مسارا كاملا للثورة والتحول الديمقراطي، أو يؤسس لجمهورية ثالثة، قوامها سلطة القانون والمؤسسات. ومهما يكن من أمر، فإن التونسيين، نخبا وشعبا، لا يقبلون العودة إلى الوراء والتضحية بمكتسباتهم في الحرية والكرامة.
العربي الجديد
———————————-
هل يلجأ قيس سعيّد لاستفتاء على تغيير النظام السياسي؟/ آدم يوسف
انقضت الأيام الأربعة الأولى من مدة الشهر التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيّد أمام المنظمات الوطنية والمجتمع الدولي لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، من دون أن يكشف عن خريطة طريق للتغييرات التي ينوي إدخالها على النظام السياسي والانتخابي، ولا القرارات الاستثنائية لإنهاء الخطر الداهم الذي دعاه لإقالة الحكومة وتعطيل المؤسسات وتجميد البرلمان. ولا يعلم أحد نوايا سعيّد الحقيقية، سوى ما أعلنه من عناوين كبرى في “بيانه الصفر” عشية احتفال تونس بذكرى قيام النظام الجمهوري وإنهاء الملكية، مساء الأحد الماضي، أمام قيادات عسكرية وضباط، إذ اكتفى بالقول إن “المسؤولية التي نتحمّلها تقتضي منا عملاً بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع”.
ولا تخفى على التونسيين مناهضة سعيّد للنظام السياسي القائم ورفضه للنظام الانتخابي المعتمد وانتقاده للدستور ومحتوياته حتى قبل توليه الرئاسة، إذ صرح في وقت سابق، بأن “التجربة أثبتت أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أديا إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة”. كما قال سعيّد خلال لقاء عقده في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي بحضور رؤساء الحكومات السابقين، إنه “لا يمكن معالجة الوضع بالطرق التقليدية، بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية، ومن بينها القانون الانتخابي، إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور”.
ويبدو أن تحقيق التصوّر الجديد الذي فكر فيه سعيّد منذ أشهر، انطلق بقراراته الأخيرة، والتي نصّت على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة والإمساك بالسلطة التنفيذية بكاملها، بانتظار الكشف عن شكل وإجراءات تغيير النصوص القانونية والدستورية من دون العودة للبرلمان وفي فترة شهر تنتهي يوم 25 أغسطس/ آب المقبل، كما جاء في محتوى التطمينات والضمانات الشفوية التي أعلنها.
وتقف عقبات إجرائية وقانونية عدة أمام تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في غياب المحكمة الدستورية وتعليق عمل البرلمان، ما يجعل من سيناريو إجراء “استفتاء”، من دون أرضية دستورية أو غطاء قانوني، المنفذ الوحيد لتحقيق ما يبحث عنه سعيّد. وينظم القانون الانتخابي في البند 131، سبل وإجراءات الاستفتاء، بطرح سؤال على الناخبين تكون إجابته بنعم أو لا على المسألة المطروحة للاستفتاء.
وقد يطرح سعيّد ثاني استفتاء في تاريخ البلاد، إذ شهدت تونس استفتاء وحيداً في تاريخها تم تنظيمه في 26 مايو/ أيار 2002 وأدى إلى تنقيح جوهري للدستور من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أحكم به قبضته على البلاد من خلال التمديد لنفسه لأكثر من ولاية، في وقت كان الدستور ينص على ولايتين رئاسيتين فقط.
وعن ذلك، قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن اللجوء في الوضع الحالي إلى تغيير النظام السياسي أو إدخال تعديلات على القانون الانتخابي من دون العودة إلى البرلمان الذي تم تجميده وتعليق اختصاصه التشريعي يعد “إجراءً خارج الإطار الدستوري”. وأوضحت أنه “لا يمكن الاستفتاء إلا على نص صادق عليه مجلس نواب الشعب، وأي استفتاء على نص من دون العودة للبرلمان هو استفتاء مخالف لدستور 2014 ولا أساس دستورياً له”.
ولفتت الدريدي إلى أنه “لا يمكن تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي بأوامر رئاسية، لأن الأوامر تزول بزوال أسبابها”، كما “لا يمكن للرئيس إصدار مراسيم منظّمة للانتخابات وللسلطة العمومية، لأن المراسيم تُتخذ في حالة حل البرلمان تماماً”. وأوضحت أنه “من الناحية السياسية يمكن للرئيس إجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي من دون أن تكون له أرضية دستورية، على غرار تأويله الفصل 80 وتجميده أعمال البرلمان، على الرغم من عدم وجود نص يفيد بذلك”. وشددت على أن “القرارات والتدابير التي يتخذها سعيّد لا يمكن الطعن فيها أو إبطالها بسبب غياب المحكمة الدستورية من جهة، بالإضافة إلى تمتعها بغطاء المشروعية القانونية والسياسية من جهة أخرى”، مشيرة إلى أن “المحكمة الإدارية غير مختصة في هذا المجال ولا يمكنها أن تحل محل المحكمة الدستورية، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (المحكمة الدستورية الوقتية) مختصة في دستورية مشاريع القوانين فقط ولا تقوم بأعمال المحكمة الدستورية”.
مقابل ذلك، يؤكد خبراء في القانون الإداري أن قرارات رئيس الجمهورية تُكيَّف كـ”أعمال السيادة” وهي نافذة بمجرد إعلانها، ولا يمكن النظر إليها من زاوية شرعية القرار الإداري طالما كان سندها الدستور والفصل 80 تحديداً، الذي يسند للرئيس صلاحية اتخاذ قرارات ترتيبية وتشريعية ودستورية أيضاً، وهي محصنة من الطعن قبل انقضاء مدة التدابير الاستثنائية.
من جهته، اعتبر خبير القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هناك سيناريوهات مستخلصة مما حدث يوم 25 يوليو، وتقوم الفرضية الأولى على تمديد الرئيس المدة التي حددها بثلاثين يوماً عند انقضائها، فيمددها لثلاثين يوماً أخرى، ومع انتهاء هذا الأجل قد يستند إلى حالة الطوارئ التي مددها أخيراً ستة أشهر، أي إلى شهر يناير/ كانون الثاني 2022. ورجح الخرايفي الفرضية الثانية التي تقوم على “إعداد مشروع قانون تنظيم للسلطات مؤقت، يتضمن كل ما جاء به دستور 27 يناير 2014 من ضمان للحريات والحقوق الأساسية واستقلال القضاء والقضاة والمحكمة الدستورية وتفريق السلطات ومدنية الدولة والنظام الجمهوري”. وأضاف “مقابل ذلك، توحيد السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ووضع آليات رقابية صارمة وفعالة بيد البرلمان لمراقبة رئيس الجمهورية، على أن يكون هذا التنظيم المؤقت مشروع دستور للجمهورية الثالثة يُعرض على الاستفتاء الشعبي”.
العربي الجديد
——————————
تونس: تباين في المواقف وقلق على الديموقراطية ومستقبل البلاد/ خولة بو كريم
“ما افتكَّ منّا بالقوة لن يعود إلاَّ بالقوّة وقرارات قيس سعيّد باطلة”، هتفَ رجل ستيني وهو يقف على البوابة الرئيسية لمقر البرلمان التونسي ضمن تجمعات احتجاجية على قرارات الرئيس التونسي الأخيرة.
كان الشارع المقابل لبوابة مجلس نواب انعكاس واضح لانقسام الشعب بين مؤيد لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين معارض لها. إذ تحول إلى ساحة مقسومة إلى شقين، تتوسطهما الشرطة التي حالت دون التحام مؤيدي الرئيس ومؤيدي “الشرعية” وحركة “النهضة”.
انتشار أمني كثيف في كل مكان، مع مدرعة للجيش الوطني التونسي تحرس بوابة البرلمان. هتافات على اليمين تنادي “يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح… يا سعيد يا بوها النهضة ن…وها”.
ومن الجهة الأخرى “يسقط الانقلاب” “يا سعيد يا جبان البرلمان لا يهان”.
هكذا بدا المشهد أمام البرلمان، وهو لم يختلف كثيراً عن الصورة في الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي التي كانت لساعات ساحة للمبارزات بين المواقف المؤيدة والمعارضة. وإن خفتت حدة المواقف المتباينة من قرارات قيس سعيد ، إلا أن السؤال الذي طرح بقوة، ماذا بعد؟ وطالب كثر بضرورة بدء إجراءات المحاسبة والمساءلة للفاسدين وبخاصة المسؤولين الذين اضطلعوا بمناصب عليا في الدولة وأضروا بمصالح التونسيين وتحوم حولهم شبهات نهب المال العام.
يوم المشاورات والقرارات
وبعيداً من البرلمان، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعقد مشاورات حثيثة مع المنظمات الوطنية والحقوقية محاولاً كسب دعمها.
وكان سعيد أخذ سلسلة قرارات بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وفرض حظر تجول وسلسلة خطوات أثارت الكثير من القلق داخلياً وخارجياً.
ففي حين عبر مناوئون لحركة “النهضة” عن ارتياحهم لما أقدم عليه سعيد إلا أن كثيرين في المقابل تخوفوا من استفراد شخص الرئيس بالسلطة.
الناشط السياسي غسان بن خليفة اعتبر أن قيس سعيّد قد “تعسف” على تأويل الفصل 80 من الدستور كما “تعسفت” حركة “النهضة” على تأويل الديموقراطية وبخاصّة في تجسيد “الوفاء لثورة الشعب”. ويرى أن النقطة الأهمّ تكمن في الجوهر السياسي للموضوع وتبعاته.
وعلّق بن خليفة مخاطباً سعيد، “من نكّل بالشعب التونسي في معاشه وصحته وحوّل ثورته إلى غنيمة لم يكن النهضة أو نواب البرلمان وحدهم. بل انّ هؤلاء هم شركاء وغالباً أعوان تنفيذ لرجال الأعمال، وقد تملقت اليوم رئيس اتحادهم وأجلسته إلى جانبك”.
تعليق خليفة اتى بعد لقاء قيس سعيد رجل الأعمال ورئيس “اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”، سمير ماجول.
ورأى بن خليفة أن تصحيح المسار الثوري الذي يريد سعيد تنفيذه يأتي عبر الحفاظ على القطاع العمومي، باتخاذ إجراءات جذرية لمصلحة الطبقات الشعبية المفقرة والمناطق المهمشة، وليس بطمأنة “أصحاب المليارات” والسفارات على مصالحهم وفق تعبيره.
الديبلوماسي السابق هيثم بلطيف يوضح لـ”درج” أن “قرارات رئيس الجمهورية سياسية وليست قانونية”، مشيراً إلى أنه من الواضح أن هذه القرارات رتب لها منذ مدة، وأنه من المؤكد أن تونس قدّمت تطمينات ومعلومات أوفر لشركائها الدوليين من الفاعلين الحكوميين من المنظمات الكبرى، بأن التطور الحاصل في تونس لن يمس بمصالح هؤلاء، وأنه شأن داخلي غايته إصلاح تعثر مسار ديموقراطي، على حد تعبيره.
ويضيف بلطيف: “الحجة التي استند إليها سعيد هي أن الدستور التونسي لا يمنع تجميد عمل المجلس، لكنه يمنع حلّه، وهي الحجة الأكثر قوة التي تقوي قرارات الرئيس”.
وعلى رغم أن 26 تموز/ يوليو كان يوماً حافلاً بالقرارات، والأعين كلها متوجهة نحو رئاسة الجمهورية، إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن حادثة اقتحام مكتب شبكة “الجزيرة” في تونس، من قبل 20 رجل أمن وطرد كل الزملاء الصحافيين والعاملين فيه، من دون إذن قضائي، ومن دون تقديم تفسيرات وتبريرات رسمية لا من وزارة الداخلية، ولا من رئاسة الجمهورية. حادثة استنكرتها منظمات دولية منها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وهي من دون شك تعدٍ صارخ على أهم مكسب من مكاسب الانتفاضة التونسية، أي حرية التعبير والصحافة.
ماذا بعد ؟
دائماً كان يُنظر الى تونس باعتبارها النجاح الوحيد للثورات العربية، لكن القرارات الآخيرة أغرقت البلاد في أعمق أزمة سياسية منذ عقد، خصوصاً أنها جعلت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الآن في يد رجل واحد.
في السنوات الماضية، شهدت تونس ارتفاعاً في معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو 18 في المئة، و40 في المئة بين الشباب، في ظل وباء “كورونا”. كما عانت البلاد من هجمات إرهابية عدة.
وما فاقم التدهور الاقتصادي والسياسي هو الخلاف على الدستور بين مكونات الحكم الحالي وهو أمر كان يفترض أن تعالجه المحكمة الدستورية. ومع ذلك، بعد 7 سنوات من الموافقة على الدستور، لم تتشكل المحكمة الدستورية التي يفترض أن تحسم الجدل، بسبب خلافات حول تعيين القضاة.
الخوف الرئيسي حالياً في تونس هو من الانحدار السريع إلى العنف فيما تملأ مجموعات مختلفة الشوارع إما للاحتفال أو لإدانة تصرفات الرئيس.
درج
———————
عشر سنوات من الدم التونسي المُراق حقيقة ومجازاً/ صلاح بن عياد
غريب هو التهافت والتسرّع اللذان اتصفت بهما آراء وردود جيراننا وأشقائنا العرب حول ما حدث في تونس في الآونة الأخيرة. أحكام مطلقة لم تترك للنقاش ثغرة. آراء ذات وجهة واحدة لا تقبل الآراء المخالفة. فتوافدت عناوين من قبيل: انقلاب بمباركة عسكرية، تهديد للمسار الديمقراطي والحريات الخ…
لماذا لا يبذل إخوتنا العرب جهداً بسيطاً من أجلنا؟ كأن يبحثوا قليلاً في المسألة السياسية التي امتدت منذ الإطاحة بنظام بن على الأسبق. عشر سنوات غامضة لا يفهمها إلا من اكتوى بنارها. خطاباتها متضاربة: إذ هي في الظاهر ديمقراطية تامّة المعالم، نعيم من الحرية والاعتدال، حزب إسلامي تحول بعصا سحرية إلى حزب مدني وفصل بين الدَعَوي والسياسي، دكاترة في الحكم، في الطب والسياسة وعلم الاجتماع، شرائح اجتماعية بسيطة لا تحمل ربطة عنق، متواضعة تمشي جنباً إلى جنب مع البسطاء في الأسواق…
إلى آخره من ذلك البهرج الذي سحر لب جيراننا، فتحوّلت تونس إلى معيار المعايير ومحرارٍ تُقاس به درجة الديمقراطية في المنطقة… أليس كذلك؟
عشر عجاف
حسناً! ألَمْ يأتكم نبأ تدليس العقول الذي تم اعتماده كعملة انتخابية على مدى السنوات العشر العجاف؟ ألم يأتكم نبأ الشيوخ والدعاة وهم يقتفون أثر المفطرين خلسة في مقاهٍ تغطيها جرائد، وبالجرائد أخبار يومية عن اشتعال السوق واشتعال الرؤوس شيباً؟
ألم تخبركم شاشاتكم عن كمّ الاغتيال السياسي الذي استهدف الذكاء التونسي؟ ألم تروْا رأسَ راعيين مقطوعيْن في ثلاجة الأم التي شقت صدرها لمجابهة الجبل المجاور الذي لم يعد آمناً؟ ألم تروا جملة الرؤوس المقطوعة لجنود يحملون أحلاماً بسيطة في تمام الشباب والنعومة؟ ألم تروا كيف كانوا يشترون صوت الناخب ببضعة مليمات وبسندوتش حقير أو بصلاة كاذبة أو بدم تونس على قمصان الجميع، هل ظننتم بأن ذلك الدمَ دمُ ذئب؟ لا يا سادتي، هي عشر سنوات من الدم المراق واقعاً ومجازاً.
عشر سنوات عدنا فيها لخوض قضايا كادت تمحو مجهود أجدادنا الذي يمتد إلى ثلاثة آلاف سنة، خضنا نقاشات حول ختان المرأة وطمس الوجه بقماشة سوداء، أقاموا خياماً في حضارتنا المعمارية، هرّبوا البطون الخاوية إلى وهم جنّة قريبة في الآخرة، اغتصبوا أطفالاً تحت الذكر الحكيم، جابهونا بالتكفير كلما فكّرنا، تتبعونا بسياسة عمرو بن العاص كلما مارسنا فناً، هشموا شاشاتنا صارخين “الله أكبر!”…
خرج وزير الإسلاميين وقال إن الذين يقطنون الجبال إنما هم شبان مبتهجون بالحياة ويمارسون الرياضة ويملؤون صدورهم بالهواء النقي، صدّروا من أولئك الشبان آلافاً إلى جهات عدة من العالم، اسألوا أول سوري يعترضكم عن “التونسي”، اسألوا أول فرنسي، لم يعد التونسي ذلك الذي ترونه في البطاقات البريدية بشاشية حمراء وشاربين دقيقين وبابتسامة بشوشة، يقول حيثما وطئ بقدميه: عسلامة، برشا برشا يا مدلل…
وهل ألقيتم نظرة على المجلس النيابي الذي تم الانقلاب عليه من لدن رئاسة الجمهورية التونسية؟ هل تعرفون مكوناته؟ هل رأيتم صورهم؟ هل هم تونسيون؟
تعالوا أحدثكم كيف جرت الأمور هنا: لقد استهدفوا شعباً تم سلبه من عمقه، عملوا حثيثاً على ذلك، سربوا كلمات سحرية: “حالة وعي”، “أبناء الفلاقة”، ونصبوا منهم متحدثين في بلاتوهات التلفزيونات كي يغزوا البيوت، البيوت الخربة التي خرّبتها سياسة بثّ الحمق والبلادة والتدني الأخلاقي، مجلس ينعق فيه المتهرّب من القانون والمهرّب للسلع والفتوّة العاضّ على لسانه، ومن أطلقت آلاف الزغاريد لمنظوماتٍ سابقة، ومتكرّش وبليد ومتحذلق ومن لا تُحسن قراءة نصّ بسيط…
مجلس انقلب على أحلامنا. وإني أحدثكم، أنا الأربعيني الذي شارك في إسقاط “الزين” وأخفق في اسقاط “العابدين”. تكاثر العابدون لعشر سنوات، عبدة الفساد وامتصاص دم الشعب الذي تحوّل إلى أتعس الشعوب على وجه البسيطة. انقلبوا على مطالبنا وحولوها إلى مطالب ميتافيزيقية وأخرى تاريخية، انقلبوا على الأصل الواحد لشعب موحّد ومتأصّل وشتتوه إلى مسلمين وكفار.
حولوا الإسلام إلى موضة. أصبح أتباعهم يفوحون برائحة الكسكسي في المساجد، بينما يفوح معارضوهم برائحة البيرة في الشوارع الخلفية. فتحوا المجال واسعاً أمام الرداءة والمغالطة.
هذا هو مجلسنا الذي انقلب عليه الرئيس مستخدماً مادة من الدستور، كتبوها هم بأيديهم المرتعشة لمدة ثلاث سنوات دفعنا فيها الغالي والنفيس. الرئيس أستاذ حاذق في القانون الدستوري. درّس آلاف الشبان وهم من انتخبوه. لم يجد في بادئ الأمر سوى أن يعانق كل من اعترضه من الشعب المتعب والشقي.
ابحثوا عن تلك الصور: كان يعانقهم كمسلوب الحيلة والإرادة، لأنهم وضعوا كل الصلاحيات في ذلك الوكر الذي أسموه مجلساً نيابياً. ثم التجأ الرئيس إلى الشعر وإلى عمر بن الخطاب وحمل الكراتين مع الحمالين. ثم التجأ إلى المقاهي الشعبية يقاسم قهوته الرديئة معهم.
هل آتاكم خبر إبادتنا الأخير؟ إننا نكاد ننتهي في هذا البلد الصغير… لقد اختطف الوباء العالمي الجديد أحباءنا من كل جهة. نحن لا نثق في إحصائياتهم. يقولون إن عدد المتوفين يشارف العشرين ألفاً. وتأكدوا بأن هذا الرقم لا يرقى إلى أن يكون عُشر الرقم الحقيقي. وماذا كان يناقش المجلس في تلك الأثناء؟ (الأثناء: جنازات في كل ركن من البلد، أكسيجين منقطع عن كل ركن من البلد، فاقة وجوع في كل ركنٍ من البلد) لقد كانوا يناقشون قانوناً حول “التعويضات”…
تعويضات ماذا أيها الأشقاء؟ إنها تعويضات لعدد ركعات الصلوات التي صلّوها في سجون بن علي، تعويضات لنضالاتهم التي لم تخدم الشعب في شيء، أوهامهم التي يريدون لها أن تتحول إلى رأس مال.
في حين مازال جرحى ثورة تونس 2011 على كراسيهم أو على أسرّتهم، عجّزاً وصماً بكماً، لا تسعفهم اللغة ليقولوا كلمة واحدة، ومازال أبناء محافظة سليانة الذين عمدوا إلى فَقء عيون شبانها المتظاهرين بالرشّ كيلا يرون النورَ إلى الآن، ومازال دكاترة البلد من الشبان ينامون أمام وزارة التعليم العالي ومنهم تفوح رائحة البول واليأس.
من هو حقاً قيس سعيد؟
إنه شخص بسيط ومتعب مثل الشعب التونسي، وهو الآن يخاطر بحياته ويطلق آخر ما تبقى من رصاصاته الأخلاقية. عن أي انقلاب تتحدثون، وقد خرج مناصرو هذه الحركة بالآلاف، زغردت النسوة، نفس النسوة اللاتي انتخبن المذكورين أعلاه وقد علّمتهن مرارة الحياة خطأهن. هب شيوخ وكهول يركضون رغم خطورة “الدلتا” الهندية التي نكادُ نراها في كل مكانٍ وصرخوا عالياً.
عن أي انقلابٍ نتحدّث، ولم يفعل “قيسون” البسيط سوى أن انحاز لما تبقى من هذا الشعب؟ عن أي انقلاب، يا أخ ويا أخت العرب؟ هل ثمة انقلاب يسمح للمنقلب عليهم أن يشتموا في القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية والخارجية وأن يحللوا وينددوا، حتى أنهم تراجعوا بعد ثلاثة أيام وأصبحوا يتحدثون عن “تجاوز بسيط للدستور”، وطالب بعضهم البعض الآخر بمراجعة النفس في محاولة لإنقاذ ماء الوجه، مع أن لا ماء بوجوههم.
القليل من البحث كافٍ لتعرفوا أيها الأشقاء بأن ما يحدث في تونس هذه الأيام هو عبارة عن محاولة الغريق التمسك بقشة، وهذه القشة “قيس سعيد”، الأستاذ الجامعي البسيط.
ننتظر مباركة ودعماً أيها الأشقاء، نحتاج تفهّماً وبعض الجهد لفهم مجريات الأمور. وإننا ننهي هذه المادة بالمعطى التالي: القنوات التي تتحدث عن الانقلاب هي قنوات لم تتعلم الدرس التونسي البليغ، إذ لشعبنا ميزة هي: التدخل في الساعة الحاسمة.
رصيف 22
—————————
كتبتُ مقالاً باسم مستعار لأول مرّة”… قلق في تونس على حرية الصحافة/ حياة بن هلال
لم تحقق الثورة التونسية مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، لكنها نجحت في ضمان حرية الرأي والتعبير، رغم العراقيل والصعوبات التي شهدتها البلاد، فقد تعددت وسائل الإعلام المحلية وفتحت المكاتب العربية والعالمية مكاتب لها في البلد الذي شهد مساراً ديمقراطياً أشاد به الجميع.
الآن، وبعد القرارت الأخيرة التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة وتوليه بنفسه السلطات الثلاث، باتت المخاوف من فقدان هذا المكسب حديث الساعة في تونس.
آلاف التونسيين خرجوا مساندين للقرارات وآخرون خرجوا للتعبير عن اعتراضهم عليها، وتجمهروا أمام مقر البرلمان في باردو، في العاصمة، وسط تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة. وتوجّه الصحافيون إلى هنالك لتغطية الأحداث ولكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها. صدمتُهم كانت كبيرة عند تصدّي العناصر الأمنية لهم وحجز هواتفهم والتضييق عليهم أثناء عملهم.
تروي مراسلة قناة الحوار اللندنية وموقع عربي 21 حليمة بن نصر لرصيف22 ما حصل معها وتقول: “بينما كنتُ أنقل الأحداث على المباشر، طوّق أكثر من سبعة أعوان (عناصر) من الأمن المكان وسلبوني هاتفي عنوةً ومنعوني من مواصلة العمل، وعندما حاولتُ الدفاع عن نفسي أمرني عون منهم بالسكوت وهددني بكسر الهاتف رغم أن كل وثائقي قانونية وأرتدي سترة الصحافة”.
استغراب وصدمة
لم يكتفِ الأعوان بسلب حليمة هاتفها ومنعها من التصوير، بل عمدوا إلى منع بقية زملائها المتواجدين هنالك أيضاً من العمل بحرية، على غرار الصحافية في موقع تونس الرقمية مروى خميسي وزميلها المصور محمد عبد الله.
تقول مروى لرصيف22: “كان الأمنيون يرصدون كل الصحافيين الذين يبثون الأحداث بشكل مباشر، وحال مباشرتنا العمل والتصوير، أرغمنا عون الأمن على تسليمه هاتفي وعندما عارضت التخلي عن هاتف العمل أمرنا بالذهاب معهم إلى مركز الشرطة. وفي الطريق إلى هنالك أخرجتُ هاتفي الشخصي من جيبي للاتصال بإدارة المؤسسة التي أعمل معها لكن أحد الأمنيين سحب الهاتف من يدي بقوة ومنعني من ذلك”.
تروي مروى ما حصل معها وهي في حالة استغراب وصدمة مما طالها وطال زملاءها، و”جرمهم” الوحيد هو نقل الحقيقة مباشرة إلى المتابعين المتعطشين لأية معلومة عن الوضع الحرج والاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
ولم يقتصر قمع الأمنيين للصحافيين على منعهم من التصوير ونقل الأخبار في ساحة البرلمان، بل جرى التهجم على مكتب قناة الجزيرة في تونس وطرد العاملين فيه بتعسف وحجز المعدات.
يقول المنتج في مكتب القناة محسن المزليني: “كنت وثلة من الزملاء بصدد العمل في المكتب وفوجئنا بدخول قرابة 20 عوناً من أعوان الأمن من الباب الخلفي، ودون سابق إنذار طالبونا بالمغادرة وغلق المكتب تحت ضغط أمني رهيب واحتجزوا المفاتيح ومنعونا من الاقتراب”.
ولم يتوقف الاعتداء على صحافيي قناة الجزيرة عند غلق المكتب فقط، بل قطعوا البث المباشر عن الصحافيين الميدانيين وعمدوا إلى التشويش على اتصالاتهم، بحسب المصور الصحافي في الجزيرة الإخبارية أنيس إدو الذي قال إن زملاء من وسائل إعلام أخرى أخبروه أن أمنيين يبحثون عنه وزملائه في الجزيرة أثناء الاحتجاجات.
“لا نريد العودة إلى الوراء”
لم يعش الصحافيون والإعلاميون التونسيون مثل تلك المضايقات منذ اندلاع الثورة التي أتاحت حرية التعبير، خاصة للصحافيين.
تقول الصحافية في الإذاعة التونسية أسماء بن بشير: “صُدمت عندما رأيت مدرعات الجيش تطوق مقرات الإذاعات والقنوات العمومية ليلة خطاب الرئيس… فعلاً إنه مشهد مروّع لم نألفه في تونس الثورة ولم نره إلا في الانقلابات الكبرى في العالم”.
وتضيف لرصيف22: “نحن كصحافيين أحرار نرفض قطعاً مثل هذه الممارسات الدكتاتورية التي بدأنا نلمسها حتى في خطابات الرئيس عندما ندد بالمس بهيبته وعند تعليقه قبل أيام على ترتيب مكالماته الهاتفية في نشرة أخبار القناة الوطنية الأولى… لا نريد العودة إلى الوراء ويجب ألا يسكت الصحافيون التونسيون الأحرار عن القمع الذي بدأوا يتعرضون له”.
“لأول مرة أكتب مقالاً باسم مستعار”، تقول سلمى (اسم مستعار)، وهي صحافية في إحدى الجرائد المحلية ومتعاونة مع موقع عربي، والعَبرات تخنقها.
وتضيف لرصيف22: “كتبت مقالاً انتقدت فيه الانقلاب على الشرعية ولكنّي لم أتجرأ على توقيعه باسمي كما تعوّدت، خاصة بعد أن رأيت الاعتداءات المتواصلة على زملائي من قبل الأمنيين. وما راعني أكثر أن رئيس التحرير في مؤسستنا المحلية أيضاً نبّهنا إلى عدم نقد الرئيس كما تعودنا خوفاً عليه وعلى مؤسسته، والأدهى أنه سيغيّر خطه التحريري تماماً… نحن مستاؤون جداً لكننا متفائلون ونأمل أن يكون الأمر مؤقتاً وأن تعود حريتنا التي سُلبت منا في يومين”.
وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن قلقها مما تعرض له الصحافيون من قمع واعتداءات في بيانات متتالية، وعقدت اجتماعاً مع منظمات حقوقية نوقشت فيه سبل الحفاظ على حرية التعبير والصحافة وردع كل تصرف من شأنه المساس بها.
تقول العاملة في وحدة الرصد في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خولة شبح لرصيف22: “ندين بشدة ما تعرّض له زملاؤنا وقد سجلنا جميع الأسماء والاعتداءات ولن يذهب حقهم هدراً”.
وعبّر مدير مرصد الحقوق والحريات في تونس أنور أولاد علي عن أسفه حيال ما حصل، وقال لرصيف22 إن تنصيب رئيس الجمهورية لنفسه رئيساً للنيابة العمومية “قرار خطير وخرق للدستور والقانون ومس بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل سافر في القضاء”.
وأدان الاعتداءات التي تعرّض لها الصحافيون من قبل قوات الأمن ووصفها بالخطيرة واعتبرها تهديداً صارخاً للحريات والديمقراطية وأضاف: “لدينا مَن يتعطش للقمع والاستبداد وأرجو ألا تكون هذه الأحداث فرصة لعودة التضييق على حرية الإعلام والصحافة، وأدعو السلطات التونسية إلى تحذير منظوريها وعدم العودة بنا إلى الوراء”.
رصيف 22
—————————–
الغنوشي يحذّر من استخدام العنف لقمع معارضي قرارات سعيد: 500 ألف مهاجر تونسي سيصلون أوروبا
حذر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، من ذهاب الأجهزة الأمنية إلى استخدام العنف والقمع ضد معارضي قرارات الرئيس قيس سعيد قد ينزلق بالبلاد نحو الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما قد يدفع آلاف التونسيين للهجرة.
وفي حديث لصحيفة Corriere della Sera الإيطالية، بعد أيام من قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، حذَّر الغنوشي أوروبا من أن سواحلها ستشهد نزوح أكثر من 500 ألف مهاجر تونسي، إن استمرت دوامة الفوضى والإجراءات غير الدستورية في البلاد.
وقال الغنوشي في إطار تحذيره: “إن الذهاب إلى الإجراءات الدكتاتورية والقمع من قبل القوات الأمنية قد يدفع للانزلاق بالفوضى، وهو ما يمكن للإرهاب أن ينمو بسرعة، وما قد يدفع الناس إلى المغادرة بأي شكل من الأشكال أيضاً”.
وفي كلمات محددة، جدَّد الغنوشي رفضه لقرارات الرئيس سعيد، واصفاً إياها بـ”الانقلاب”؛ حيث قال: “لقد ارتكب أخطاء جسيمة ضد الدستور، يريد السيطرة على السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
ومع تأكيده على انقطاع وسائل التواصل مع الرئيس التونسي، فقد أكد الغنوشي على موقف حزبه بأن “أي رئيس وزراء أو حكومة قادمة يجب أن يشرِّعها البرلمان الحالي”، قائلاً: “لا توجد وسيلة أخرى”.
وفي إطار الإجابة على سؤال عن رد فعل حزب النهضة، أجاب الغنوشي: “سنقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية، وسنناضل من أجل عودة الديمقراطية، يجب أن يفهم أن البرلمان يجب أن يعود إلى مركز آليات صنع القرار في الدولة”.
مستعد للتنازل
وكان الغنوشي قد قال الخميس إن حزبه مستعد لتقديم أي تنازلات “من أجل إعادة الديمقراطية للبلاد”.
ففي حوار له مع وكالة “فرانس برس”، شدّد الغنوشي على أن “الدستور أهم من التمسك بالسلطة”، كما دعا إلى حوار وطني؛ وذلك في مبادرة جديدة من الحزب الإسلامي إلى الرئيس التونسي.
غير أن الغنوشي، أكد كذلك أنه “سيدعو الشارع من أجل الدفاع عن الديمقراطية في تونس، والتحرك لرفع الأقفال عن البرلمان”، وذلك في حال عدم الوصول لأي اتفاق بخصوص الحكومة القادمة وعرضها على البرلمان.
“قرارات تصعيدية”
كان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الجاري، أنه قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولّي النيابة العمومية بنفسه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014، الذي وزَّع السلطات بين الرئيس ورئيسَي الوزراء والبرلمان.
سعيّد قال إنه اتَّخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الأمر الذي نفاه الغنوشي لاحقاً.
بينما برّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر بأخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.
جاءت قرارات سعيّد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
“انقلاب على الثورة والدستور”
رداً على تلك القرارات، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” رئيس البرلمان التونسي، الرئيسَ قيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور، مضيفاً: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
الغنوشي أشار، في تصريحات إعلامية، إلى أنه “مستاء من هذه القرارات”، متابعاً: “سنواصل عملنا، حسب نص الدستور”.
كما وصف عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، نور الدين البحيري، القرارات الأخيرة بأنها “انقلاب مروّض” على الدستور والشرعية، منوهاً بأنهم سيتعاطون مع “هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور والانقلاب على مؤسسات الدولة، وسنتخذ إجراءات وتحركات داخلياً وخارجياً لمنع ذلك (سريان تلك القرارات)”، دون ذكر توضيحات بالخصوص.
بخلاف موقف “النهضة” (53 نائباً من أصل 217)، عارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيّد؛ إذ اعتبرتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعداً) “باطلة”، ووصفتها كتلة قلب تونس (29 نائباً) بأنها “خرق جسيم للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ما ترتب عليها، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (15 نائباً) (قومية).
جدير بالذكر أنه يُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى، شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
عربي بوست
———————————
المفكر العربي عزمي بشارة: سعيّد يعمل على تسييس الأجهزة الأمنية في تونس
قال المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة في تغريدات على حسابه في تويتر إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يسعى من خلال تعيين وزير داخلية ووزير دفاع ومدير مخابرات موالين له، إلى تسييس المؤسسة الأمنية.
وكتب بشارة في تغريدة اليوم الجمعة: “كل من كانت لديه شكوك أو أوهام بشأن إجراءات الرئيس التونسي يفترض أن يدرك الآن النوايا. ما دخل الأمر القاضي باحتمال تمديد تجميد البرلمان وتعيين وزير داخلية ووزير دفاع ومدير مخابرات الداخلية موالين له (أي تسييس المؤسسة الأمنية) بأزمة اقتصادية اجتماعية أو صحية؟”.
يتوسع خرق البند ٨٠ من الدستور باحتمال تمديد تجميد البرلمان، واضافة الى ذلك تتخذ خطوات لتسييس الاجهزة الامنية وضمان ولائها! لا علاقة لهذا بالخطر الداهم الذي جرى الحديث عنه، بل باهداف اخرى يجري العمل على تحقيقها خطوة خطوة. الذي ينتظر ماذا سيفعل الرئيس واهم. انه يفعل !!
— عزمي بشارة (@AzmiBishara) July 30, 2021
وأكد المفكر العربي على أن التوسع في خرق البند 80 من الدستور باحتمال تمديد تجميد البرلمان “لا علاقة له بالخطر الداهم الذي جرى الحديث عنه، بل بأهداف أخرى يجري العمل على تحقيقها خطوة خطوة”.
وتابع حديثه: “وإضافة إلى ذلك تتخذ خطوات لتسييس الأجهزة الأمنية وضمان ولائها.. الذي ينتظر ماذا سيفعل الرئيس واهم. إنه يفعل!!”.
ويوم الإثنين الفائت نشر المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، تعليقاً على صفحته في فيسبوك بشأن التطورات في تونس بعد إعلان الرئيس قيس سعيد، الأحد الفائت، تجميد البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى سعيد بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
وشدد بشارة على أن الديمقراطية في خطر، مشيراً إلى أن البدائل المطروحة حالياً لا تنقسم بين ديمقراطية برلمانية أو رئاسية، بل بين الديمقراطية والعودة إلى الديكتاتورية، كما شدد على أن الالتزام بالنظام الديمقراطي والدفاع عن الديمقراطية يجب ألا يخضعا للانقسامات الحزبية.
ديمقراطية في خطر
وجاء في المنشور
الذي حمل عنوان “ديمقراطية في خطر”:
1. الدفاع عن الديمقراطية مهمة القوى الحية في الشعب التونسي وليست مسألة انقسام حزبي. الالتزام بالنظام الديمقراطي ليس مسألة حزبية.
2. الديمقراطية التونسية، الديمقراطية العربية الوحيدة حتى الآن، إنجاز تاريخي لا يجوز التنازل عنه، ولا عن السعي لحل القضايا والمشاكل في إطاره مثل كل الديمقراطيات في العالم.
2. لم يتفق أي خبير دستوري أو أستاذ قانون تونسي مهم مع تأويلات الرئيس للدستور منذ تسلمه لمنصبه. وعموما، النقاش على هذا البند أو ذاك من الدستور مع طرف يعارض الدستور برمته هو نقاش عقيم، فتأويله للدستور هو مجرد غطاء لخطوات معادية للدستور.
3. جرت في تونس عملية ممنهجة مثابرة لتعطيل عمل البرلمان والحكومة. (عدم مشاورة الكتل النيابية في تكليف رئيس الحكومة، محاولة إزاحة رئيس الحكومة المكلف لأنه لم يلتزم بتوجيهات الرئيس مع أن الأمر ليس من اختصاصه، رفض الرئاسة استقبال الوزراء لتأدية القسم بتحويل إجراءات شكلية إلى مسألة جوهرية، رفض إنشاء محكمة دستورية تفصل في الخلاف بين السلطات وتنصيب نفسه خصما وحكما، تجاوز متكرر للفصل بين السلطات والتوازن بينها، محاولات لتوريط الجيش في السياسة، هذا عدا تصوير ممثلي السلطات الأخرى باستمرار في كاميرات قصر الرئاسة كأنهم تلاميذ يستمعون إلى توبيخ، التظاهر الشعبوي بالغضب الدائم من شيء ما فاسد، كذبة محاول الاغتيال التي لم يحاسب عليها، التظاهر بالتواضع للتغطية على نرجسية مفرطة ورغبة جامحة بالتفرد في الحكم، النبرة الشعبوية السافرة في الهجوم على المؤسسات والأحزاب وعلى النخب والسياسيين وكأنه ليس سياسيا، محاولات لتعطيل جلسات البرلمان من طرف ممثلة بقايا الحزب الدستوري، ومع أنها لم تنجح إلا أنها خلقت الانطباع أن البرلمان في حالة فوضى، مع أن هذا لم يكن صحيحا).
4. لا تنقسم البدائل المطروحة حاليا بين ديمقراطية برلمانية أو رئاسية، بل بين الديمقراطية والعودة إلى الديكتاتورية التي لم يُعرف عن الرئيس معارضتها حين حكم زين العابدين بن علي تونس، وفاخر بأنه لم يدل بصوته في أي انتخابات في تونس الديمقراطية. ولم يخف إعجابه الضمني ببعض نماذجه الديكتاتورية. والحقيقة أن اقتراحاته لدستور آخر لتونس تشبه نموذج اللجان الثورية التي غطت على الديكتاتورية في ليبيا، أو هي على الأقل مصاغة بنفس العقلية.
5. بعض الأحزاب التونسية رفعت الخصومة الحزبية وتصفية الحسابات فوق الالتزام بالديمقراطية. وهذا خطأ جسيم.
6. لم تنجح المحاولة بعد، والأمر متوقف على الشعب التونسي، وأيضا على درجة التعاون التي يبديها الجيش وأجهزة الدولة الأمنية مع توسيع الخطوات التي اتخذت. ومن المبكر اتخاذ موقف سلبي من الجيش.
7. ما قام به الرئيس جرى الإعداد له علنا وكان متوقعا، وسوف يكون غريبا ومستغربا إذا لم يجهز من توقعها نفسه لهذا السيناريو.
8. العنف ليس واردا إطلاقا في التصدي لهذه المحاولة. إلى أي مدى يذهب الجيش مع الرئيس يتوقف على حركة الشارع التونسي، وتماسك غالبية البرلمان في معارضة الخطوات.
9. من الممكن إنقاذ الديمقراطية في تونس.
الديمقراطية التونسية في مواجهة الشعبوية
واتبعه بشارة يوم الثلاثاء الفائت بمنشور آخر حمل عنوان “الديمقراطية التونسية في مواجهة الشعبوية
” وجاء فيه:
1. في أوج خيبة الذين “هرموا” منذ عام 2013 لأن آخر شمعة في حلكة “الاستثناء العربي” قد تنطفئ، توالت الأخبار عن مواقف النخبة التونسية السياسية والمدنية التي تراوحت بين رفض الانقلاب على الدستور والتحفظ عليه (حذرا وليس تساهلا). لقد عبّرت جميع الأحزاب السياسية، اليسارية والليبرالية (المحافظة وغير المحافظة) والإسلامية (ما خلا حزبين) موقفا رافضا من خطوات الرئيس. وتحفّظت المؤسسات المدنية الكبرى عليها، أو أبدت تحفظاتها. كما رفضت غالبية القانونيين التوانسة تفسيرات الرئيس القانونية للدستور.
2. في كتابي الأخير عن الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، وفي سياق تحليل نجاح الانتقال في تونس وفشله في مصر أكدت اختلافي مع دراسات التحديث بشأن اعتبار معايير التحديث هي الفارق الرئيس بين النجاح والفشل, مشيرا إلى الفارق المهم في ثقافة النخب السياسية بين البلدين. في تونس أبدت النخب السياسية الرئيسية استعدادا للحوار في ظل الالتزام بالعملية الديمقراطية، في حين أنه في مصر فضل بعضها التحالف مع عناصر من النظام القديم أو حتى مع الانقلاب العسكري ضد خصومها. ومنذ الأمس يؤكد رفض النخب التونسية الوازنه الانقلاب على الديمقراطية هذا الانطباع.
3. شكلت الشعبوية بوصفها خطابا ومزاجا سياسيا تحديا رئيسا للديمقراطية في تونس. ولم تتمكن الديمقراطية التونسية من التغلب عليه، بل أججته، بما في ذلك في خطاب الإعلام المتنافس على الإثارة واجتذاب المستمعين والمشاهدين (ولا سيما غير المسؤول وغير المهني منه) وفي التراشق بين الأحزاب في البرلمان (هكذ أدرّجهما من حيث المسؤولية أيضا).
4. وكانت الطامة الكبرى بانتخاب رئيس من دون سجل مهني بارز أو نضالي أو سياسي، بل بسبب خطابه الشعبوي المقعر لا غير. (من المفارقات أن من يؤجج الخطاب الشعبوي ضد النخب السياسية والحزبية والثقافية في أوساط الجمهور هم عادة عناصر وأفراد من النخبة ذاتها، وذلك لأسباب أيديولوجية أو مصلحية أو وصولية، والملفت أنه غالبا ما يكون هؤلاء من الفاشلين في مجالهم المهني الحاقدين على زملائهم، ويحولون الحقد إلى غضب وخطاب سياسي انتقامي من النخبة عموما).
4. يعاني الشعب التونسي من مشاكل اقتصادية عديدة زاد من حدتها وجود توقعات كبرى من النظام الجديد، وأدت الخيبات في بعض الحالات إلى التوق إلى النظام القديم. ولم تتمكن الديمقراطية التونسية من تلبية التوقعات وحل المشاكل بخطط وخطوات تنموية، ولا شك أن عجز الائتلافات الحاكمة، وأيضا المماحكات الحزبية ورغبة المعارضة في إفشال أي ائتلاف أسهمت في ذلك. ولم تتخذ خطوات لرفع العتبة الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان لتقليل عدد الكتل الصغيرة وتسهيل تشكيل الائتلافات وعمل الحكومات.
5. ظهرت الخيبة من البرلمان في تراجع نسب التصويت، وكذلك في التصويت في انتخابات الرئاسة لمرشح شعبوي تحول ضعفه (قله خبرته السياسية) إلى قوة لأنه بدا وكأنه ليس سياسيا. لم يكتف هذا المرشح الذي أصبح رئيسا بالمجاهرة بعدم خبرته، بل أكد أنه لم يصوت في اي انتخابات في تونس الديمقراطية. وهذا تعبير ليس فقط عن استخفاف بالديمقراطية، بل بقلة اهتمام بالمجال العام من طرف شخص رشح نفسه للرئاسة، وشعور نفسي دفين أن لا أحد يستحق ان يمنحه صوته. وهذا بنية نفسية معادية للديمقراطية.
6. إن قيام سياسيين بالتحريض على السياسة هو من أهم علامات الشعبوية المعادية للديمقراطية. فلا ديمقراطية من دون سياسة وسياسيين. الديكتاتور هو أسوأ انواع السياسيين لأنه الأكثر استخداما للتآمر والأحابيل والعنف، ولكنه يدعي الترفع عن السياسة.
7. مهمة الساعة هي تعاون النخب السياسية والمدنية الوطنية التونسية على الرغم من الخلافات في مواجهة الأخطار المحدقة بالديمقراطية. وهذا يشمل مواجهة الشعبوية بفضح أهدافها الحقيقية وبمخاطبة الشعب والإجابة على مخاوفه.
8. جميع الأنظمة السلطوية تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجميعها واجهت جائحة كورونا وغيرها. وتواجه الديمقراطيات (التي تبقى أكثر جاذبية فلم نسمع عن توانسة أو غيرهم يهاجرون للعيش في روسيا والصين وهنغاريا وبولندا فضلا عن كوريا الشمالية) مصاعب اقتصادية واجتماعية، وبعضها استعان بالجيش في مواجهة الوباء، ولكن الجيش لم ينس، خلال تأدية المهام الاستثنائية، أن عليه الالتزام بالدستور. الديمقراطيات تواجه المشاكل في إطار النظام الديمقراطي.
9. الديمقراطية بحد ذاتها هي حل لآفة الطغيان والاستبداد وضمان لحقوق المواطن، وليست حلا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. فهذه وظيفة القوى السياسية والاجتماعية وسياسات القوى الحاكمة ومؤسسات الحكم، وذلك في إطار النظام الديمقراطي الذي يجب الحفاظ عليه لأن البديل هو الاستبداد.
ونشر المفكر العربي يوم الأربعاء الفائت منشوراً آخر بشأن الأزمة الحاصلة في تونس، قال فيه:
في توقيت النقاش حول من يتحمل المسؤولية، وفي الشعبوية وما يدور في ذهن الرئيس
1. سبق أن كتبت عدة مرات محذرا من أثر ظواهر سلبية على صورة التعددية الديمقراطية لدى الجمهور التونسي، ومنها: تنقل نواب البرلمان بين الأحزاب (السياحة الحزبية وفق المصطلح النونسي) بحثا عن الفائدة الشخصية والمنصب، ونشوء أحزاب لا تمثل موقفا أو فكرا أو قضية، لا لسبب إلا لسهولة الأمر، تبدّل الصفقات الحزبية وتغيّرها بموجب تكتيكات ومن دون استراتيجية معلنة، تراشق التهم غير المثبتة لغرض المس بالخصم، أي التشهير المتبادل، المبالغة في الحديث عن الفساد والمحسوبية وغيرها لتشوية الآخرين؛ ومع أنه يوجد في بعض الحالات أساس واضح لهذه الادعاءات إلا أن كثرة تردادها وإلصاق التهمة بالجميع تنفر الجمهور وتخلق انطباعا أن جميع السياسيين فاسدون، وهذا غير صحيح؛ وأخيرا، الانطباع عن ديمقراطية بلا هيبة لا تدافع عن نفسها بوجود حزب في البرلمان التونسي يعلن على رؤوس الأشهاد أنه مؤيد للنظام السابق، وأن هدفه تقويض الديمقراطية، ويقوم فعلا بالتهريح في البرلمان وتشويه صورة التعددية الديمقراطية (بتواطؤ واع وغير واع من الإعلام المهتم بالإثارة).
2. فيما عدا الظاهرة الأخيرة، جميع هذه ظواهر قائمة في أي ديمقراطية. وفي جميع الديمقراطيات، شجع البث المباشر من البرلمان الشعبوية في خطابات النواب وفي رد الفعل في ثقافة الجمهور. وفي جميع الديمقراطيات ثعقد صفقات حزبية وائتلافات لاغراض الحكم والمعارضة. ولكن الديمقراطية حديثة العهد في تونس والجمهور ليس معتادا على هذا النمط بعد، وكان على القوى المؤيدة للنظام الديمقراطي أن تبدي مسؤولية أكبر، كما أن الانتخابات غير المقيدة وأجواء الحرية فسحت المجال ليس فقط لمؤيدي الثورة ومعارضيها بخوض غمار السياسة والمزايدات، بل أيضا للمغامرين وغريبي الأطوار، وليس فقط للصحافة، بل لشبه الصحافة في التأثير في المشهد.
3. عقّد الدستور المختلط المشهد السياسي. كان المقصود أن يكون النظام برلمانيا، ولكن في النهاية أدخلت فيه عناصر من النظام الرئاسي. المحكمة الدستورية لازمة في كل ديمقراطية، ولكن في حالة نظام مختلط معقد كهذا يصبح وجودها ضرورة ماسة، وغيابها كارثة. ففي غياب محكمة كهذه تحمي الدستور وتفسر توازناته وحدود صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان قد تتحول العناصر الرئاسية في الدستور إلى حصان طروادة ضد النظام البرلماني. لم يحصل هذا بوجود رئيس مسؤول وعاقل مثل الباجي قايد السبسي (بغض النظر عن الخلاف مع مواقفه وسيرته)، ولكن، مع وصول شخض مناهض للديمقراطية إلى سدة الحكم، تحول الاحتمال إلى خطر حقيقي.
4. النظام الرئاسي في البلدان العربية هو مشروع استبداد (وفق اجتهاد البعض يلزم صلاحيات رئاسية أوسع في البلدان العربية المتعددة الإثنيات والطوائف حيث يمكن ان تمزق المحاصصة الطائفية وحدة النظام البرلماني). ولكن تونس دولة متجانسة إثنيا ودينيا، ولا أثر فيها للنزوع إلى المحاصصة الهوياتية. والنظام البرلماني هو الأصلح لها بعد عقود طويلة من حكم الفرد المستبد. ولكن الدستور أقر، وهو دستور ديمقراطي يضاهي دساتير أعرق الديمقراطيات، ويجب ان تحميه محكمة دستورية.
5. يظهر خطر النظام الرئاسي في دول اعتادت مؤسساتها على تلقي أوامر الحاكم الفرد في سلوك أجهزة الدولة التونسية الطيع لأوامر رئيس يخرق الدستور، وذلك على الرغم من أن النخب الثقافية والسياسية لا تختلف معه فقط، بل تتحدث بجرأة متفاوتة عن سوية أعماله واقواله.
6. تتحمل الأحزاب الحاكمة في تونس مسؤولية بالطبع عما آلت إليه الأمور، وكذلك أيضا المزاودون الشعبويون الذين استغلوا عدم شعبية خطوات مسؤولة وضرورية. عند حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتخذ الحكومات في بعض الحالات خطوات غير شعبية، وتتضح في هذه الحالات قوة النظام الديمقراطي ورسوخه، وتشكل المزايدة الشعبوية في هذه الحالات أحد أهم العوائق أمام ترسيخه.
7. في تونس لم تحكم أحزاب الأغلبية البلاد في العامين الماضيين (لا يوجد حزب أغلبية بل أحزاب)، بل دعمت حكومة تنكوقراط من دون تمثيل حزبي فيها. وبدا البرلمان مكانا للخصومة والثرثرة من دون فعل حقيقي، ما سهل العمل على تشويه صورته بتواطؤ (موضوعيا على الأقل) بين الرئيس المعادي علنا للدستور القائم وعناصر معادية للديمقراطية داخل البرلمان تحولت إلى مهرج دائم فيه. ولم تكسب حركة النهضة شيئا بل خسرت من تصدرها برلمان لا تمارس الأغلبية فيه الحكم. وبدا صراع الرئيس مع البرلمان (وهو في جوهره صراع مع البرلمان على الصلاحيات) وكأنه صراع مع حركة النهضة.
8. جميع الانقلابات في التاريخ، وأهم الإنتاجات النظرية اليمينية في تبرير الديكتاتورية الفاشية (وبعضها من إنتاح قانونيين مثل كارل شميت عشية صعو د النازية) جاءت على خلفية التحريض على البرلمان (للمفارقة استخدم شميت تعبير المؤامرات في الغرف المظلمة في حديثه عن برلمان جمهورية فايمر) وتمجيد النظام الرئاسي الذي يمثل وحدة السيادة وعدم تجزئتها، وأهم تعبيراتها وفق شميت الحق في إعلان حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ عنده دائمة لأن البلاد دائما في خطر داهم. والنتيجة في ألمانيا معروفة.
9. حساب الذات ضروري، وكذلك تحمل المسؤولية، ينطبق هذا على الأحزاب التي أسهمت في تأجيج الشعبوية في الشارع. ويصح ذلك حتى على أحزاب فسدت وأخرى لم تفسَد ولكن أخطأت في اجتهاداتها وبالغت في تكتيكاتها. وعليها ان تسنتج النتائج. ولكن المهمة الحالية الملحة هي مواجهة مخطط لانقلاب على الدستور منذ كذبة محاولة الاغتيال وإلقاء الخطابات السياسية في الثكنات العسكرية فصاعدا… كيف يجوز لديمقراطي أن يستخف بهذه المهمة ويستغل الفرضة لتصفية الحسابات مع خصومه الحزبيين؟
10. تنتشر بين النخب التونسية حاليا عبارة ” لا أحد يعلم ماذا في ذهن الرئيس”، أو “ننتظر خطواته القادمة التي لا نعرف ما هي”. هذه مصطلحات نظام حكم ديكتاتوري يحكم من الغرف المظلمة (هنا يصح التعبير فعلا). فقط في تلك الأنظمة يتعلق كل شيء بأمور مجهولة تدور في ذهن الرئيس.
11. لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية بترديد هذه العبارات، بل بعكس ذلك: أ. مطالبة الرئيس أن يفصح فورا عما يريد أن يفعل وأن يكون هذا مطروحا للنقاش في البرلمان والصحافة وغيرها، فالنظام التونسي ليس رئاسيا، فضلا عن أن يكون دستورا شكليا لنظام ديكتاتوري، ب. يفترض أن يدور شيء ما في ذهن القوى الديمقراطية (المدنية والسياسية) غير انتظار ما سوف يفعله الرئيس، أقصد ان تخطط وتعلن خطتها للمرحلة المقبلة، وليس أن تنتظر ما سوف يفعل الرئيس.
12. ثمة في تونس مجتمع مدني وسياسي حي، ومؤسسات متمرسة مساندة للديمقراطية، وشعب يعاني من مشاكل وخيبات كثيرة، ومعرض بسبب ذلك للدعاية الشعبوية، لكنه شعب ذاق طعم الحرية وحقوق المواطن، وقد تصبح هذه المزايا والكبرياء الذي يرافقها جزءا من هويته الوطنية، وهذا أساس جيد لمخاطبته.
تلفزيون سوريا
——————————–
تونس على ضفاف “السيساوية”: كيف نتجنّب السيناريو الأسود؟/ إيلي عبدو
المعضلة في تونس حالياً، هي فشل في إدارة الفترة الانتقالية وقتلها بأولوية التوافق، وانفصال أحوال السياسة عن أحوال الناس، وظهور شعبوي سلطوي يقتنص الفرص للانقضاض على التجربة الدستورية الهشة أصلاً.
لا تزال الصورة غير واضحة في تونس، عقب قرارات الرئيس قيس سعيّد، القاضية بعزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، فالجيش الذي منع فعلاً نواب الشعب على رأسهم رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان، بدأ منحازاً لسعيّد، غير أن هذا الانحياز يصعب تحديد مداه والجزم بأن يكون مطلقاً. كما لا يبدو واضحاً ما إذا كان سعيّد يسعى إلى إقصاء الطبقة السياسية كلها، أم يريد تصفية حركة “النهضة” التي استُهدفت مقراتها قبل ساعات من قرارات الرئيس، ما دفع البعض إلى الربط بين الحدثين، انطلاقاً من سيناريو يقضي بإخراج الحركة الإسلامية من الحكم، وربما استئصالها نهائياً على غرار التجربة “السيساوية” (نسبة إلى عبد الفتاح السيسي).
صحيح أن الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة لـ”النهضة”، أصدرت بيانات ضد قرارات سعيّد، لا سيما تأويله للفصل 80 من الدستور، لكن الغنوشي وحده تحرك نحو البرلمان وجمع أنصاره للدعوة إلى “حماية الثورة والدستور”، ما يعني انقساماً مدنياً- إسلامياً، غير متبلور، بشكل مباشر خصوصاً أن النهضة بنت توافقات مع قوى متعددة، لكنه قابل للتبلور في أي لحظة، إذ إن القوى السياسية لديها استعداد للانخراط في أي معادلة جديدة على حساب النهضة، التي تشعر بأنها مستهدفة وتتحرك على هذا الأساس. أي أن القوى السياسية غير معنية بالدفاع عن ما بني من قواعد دستورية ضعيفة في البلاد بعد الثورة، بقدر ما هي معنية بإعادة إنتاج نفسها، بعد فقدان الشارع ثقته بها. “النهضة” لم تكن خارج، نقمة الشارع، لكنها تختلف عن بقية القوى بامتلاك بعد عقائدي– تعبوي يمكنها من التقدم في أي انتخابات، واستغلال ضعف الاخرين، وانفصالهم عن مصالح المجتمع، وهو ما حصل في الانتخابات الأخيرة حيث حصدت أكبر كتلة وبنت توافقات، سريعاً ما تأرجحت، وسط أوضاع سياسية شديدة التقلب.
إن استغلال ما يحدث للتصويب على “النهضة” بهدف تصفيتها، انطلاقاً من كونها إسلاماً سياسياً، وليست جزء من منظومة حكم غير منتج، ستكون له نتائج سلبية.
أزمة الثقة بين الأحزاب والناس، كانت نتيجة لضعف تأثير القواعد الدستورية لممارسة الحكم على أحوال المجتمع ومصالحه، فالتوافق الممل، أفرغ السياسة من كونها إدارة للشأن العام، وحول مؤسسات الحكم إلى لعبة مساومات وصراعات بين الأحزاب والقوى لا تبالي بأوضاع الناس ولا تنعكس على مصالحهم. ما يعني أن الفترة الانتقالية، التي كان من يفترض، أن تشهد تقوية المؤسسات، للانتقال إلى دولة تدير مصالح مواطنيها، أصبحت غاية بحد ذاته، وحلقة مفرغة، انتقال ينتج الانتقال، بدل أن يتطور، نحو ديموقراطية راسخة.
وانهيار الحزبية والسياسة، ضمن عملية انتقالية تأكل نفسها، كانت تتمته الطبيعية، عند شعبوي مثل قيس سعيّد، ربح انتخابات الرئاسة، نتيجة عاملين، خوف التونسيين من وصول منافسه قطب الإعلام المتهم بالفساد نبيل القروي للسلطة، واليأس من الطبقة السياسية المنشغلة بالتوافقات التي لا تترك أي أثر على حياة الناس. واليوم، لا يوجد أفضل من الظروف الحالية حيث الأحوال الاقتصادية المتردية، وخروج “كورونا” عن السيطرة، وتصاعد النقمة على السياسيين، ليعلن سعيّد قراراته.
من هنا، فإن، المعضلة في تونس حالياً، هي فشل في إدارة الفترة الانتقالية وقتلها بأولوية التوافق، وانفصال أحوال السياسة عن أحوال الناس، وظهور شعبوي سلطوي يقتنص الفرص للانقضاض على التجربة الدستورية الهشة أصلاً. بهذا المعنى “النهضة”، مسؤولة عن مشكلات البلد، ضمن مناخ سياسي واسع، وقائم على التوافق، غير أن الأخير، له مستوى آخر للفهم، غير ذاك المتعلق بالعلاقة التي أصابها الشلل بين السياسة والمجتمع في تونس. فهم يرتبط بتمايز الحركة عن أقرانها، من أحزاب الإسلام السياسي في المنطقة لا سيما مصر. فهي دخلت في تسويات سياسية، مع قوى مدنية، على عكس حزب “العدالة والحرية” في مصر الذي احتكر السلطة، بذريعة الشرعية، وحاول التوغل في مؤسسات الدولة، فضلاً عن أن علاقة النهضة بالعنف تكاد لا تذكر قياساً بحركات إسلامية أخرى في المنطقة، يضاف إلى ذلك وجود شخص مثل راشد الغنوشي، في قيادة الحركة، قام بمراجعات معمقة خلال وجوده في الغرب، وله مواقف متقدمة في قضايا كثيرة، غالباً ما تحرج أتباع الإسلام السياسي في العالم العربي، وتحرج أتباع الحركة أيضاً. أي أن الحركة تمارس التوافق، ضمن قواعد دستورية غير صلبة، ما يجعله إيجابياً لناحية قبولها بالآخر السياسي، وسلبياً لناحية الفاعلية وتحسين ظروف الناس.
وعليه، فإن استغلال ما يحدث، للتصويب على “النهضة” بهدف تصفيتها، انطلاقاً من كونها إسلاماً سياسياً، وليست جزء من منظومة حكم غير منتج، ستكون له نتائج سلبية، لناحية عدم الفرز بين تجارب الإسلام السياسي في المنطقة، وتقييمها انطلاقاً من قبولها بممارسة السياسة ضمن قواعد دستورية، ما يتيح معارضتها، وتغيير سلوكها. كما أن ذلك، لن يشكل حلاً لأزمات تونس، بل سيجعل الإسلاميين كبش فداء، لتأديب بقية القوى أو إعادة انتاجها في معادلة جديدة، تسلمه عبرها بنظام سلطوي على غرار مصر السيساوية.
لتجنب هذا السيناريو الأسود، يمكن التفكير بعيداً من شلل التوافقية، غير المنتجة، والتي تشترك فيها “النهضة”، ضمن مفارقة، ترتب سلبيات وإيجابيات، وكذلك بعيداً من حلول شعبوية يقترحها الرئيس قيس سعيد، لمنع سقوط التجربة الوحيدة، التي نجت من دول “الربيع العربي”.
درج
————————————–
=========================
تحديث 31 تموز 2021
—————————–
قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة»
استقالات وانتقادات لاذعة لقيادتها… وتحقيقات قضائية تطال 4 من عناصرها
تونس: كمال بن يونس
تسببت القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان، في أزمات سياسية غير مسبوقة داخل حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، كان آخرها الإعلان أمس عن فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم الحارس الشخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
وتوالت الاستقالات والانتقادات لأداء حزب النهضة، ورئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي لوح في تصريحات جديدة لوسائل إعلام إيطالية وفرنسية وعربية بـ«تحريك الشارع»، و«تنظيم احتجاجات شعبية واسعة»، إذا لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي، وبينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه. كما حذر الغنوشي في تلك التصريحات عواصم الغرب من مغبة «انتشار الفوضى والعنف في تونس»، ومن انعكاساتها على بلدان الجوار، وعلى تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مثلما حصل عندما مرت تونس وليبيا باضطرابات أمنية واسعة مطلع 2011.
وأمس خرجت انتقادات كثيرة من قيادات حزب النهضة ونشطائه مجدداً إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بمسؤولية الحزب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام.
وأعلن خليل البرعومي، مسؤول ملف الإعلام في قيادة النهضة، عن استقالته من المكتب التنفيذي للحركة ومن رئاسة مكتب الإعلام، احتجاجاً على ما وصفه بــ«عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل، التي وجهها لها الشعب في مظاهرات الأحد الماضي، عندما داهمت مجموعات من الشبان مقرات الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها بالتحالف مع «لوبيات الفساد»، ومع السياسيين الذين فشلوا في تحقيق ما وعدت به ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، من تشغيل وتنمية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وتزامناً مع ذلك، وجه البرلماني والقيادي في حزب النهضة، محمد القوماني، نقداً حاداً لسياسات قيادة حركته، ودعاها إلى فهم «الغليان» الشبابي والشعبي ضدها خلال مظاهرات الأحد الماضي، ثم في المسيرات الضخمة التي نظمت بعد إعلان الرئيس سعيد عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.
من جانبه، حمل لطفي زيتون، الوزير السابق ومدير مكتب الغنوشي سابقاً، قيادة النهضة مسؤولية تعثر مسار الإصلاح والتغيير خلال الأعوام الماضية، وحذرها من «سيناريو تجييش الشارع» ومحاولة «التمرد» على مؤسسات الدولة.
وفي سياق ذلك، صدرت تصريحات عنيفة تنتقد رئيس حزب النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، وأبرز المقربين منه، مع تحذيرهم من توريط البلاد في سيناريو «التصعيد وتجييش الشارع» عبر الدعوات إلى التظاهر والتجمعات، التي قد يرد عليها أنصار قيس سعيد بمظاهرات موازية وقوات الجيش والأمن بالقوة، ومن بين هؤلاء البرلماني والوزير السابق سمير ديلو، الذي سبق له أن تزعم «لائحة المائة قيادي الذين وقعوا العام الماضي» عريضة تطالب الغنوشي بالانسحاب من قيادة الحركة، وعدم الترشح في مؤتمرها الوطني الـ11 المقرر عقده هذا العام. كما اعتبر سمير ديلو أن البرلمان بصيغته القديمة «أصبح عالة على الديمقراطية وعلى الانتقال الديمقراطي والإصلاح».
في غضون ذلك، دعت قيادات سياسية من أحزاب مختلفة إلى تشكيل «جبهة وطنية تعارض القرارات الانقلابية»، التي أعلن عنها الأحد الماضي «بطرق سلمية»، مع استبعاد كل سيناريوهات المواجهة والتصعيد. وتردد أن من بين المشاركين في هذه «الجبهة الوطنية» نقابيين وسياسيين من أحزاب علمانية وليبرالية وإسلامية، على غرار تجربة جبهة 18 أكتوبر» 2005، التي تشكلت لمعارضة حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
في المقابل، دعا الوزير السابق والمعارض القوي لحزب النهضة، محمدعبو، كوادر هذا الحزب إلى التوقف عن انتقاد «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها قيس سعيد.
وطالب قيادات الحزب بتوجيه شكر إلى الرئيس سعيد لأنه «لم يعلق العمل بالدستور، ولم يحل البرلمان، واكتفى بإجراءات مؤقتة منعت الجماهير الشعبية الغاضبة من متابعة هجماتها على مقرات حزب النهضة وحرقها».
وأعلن محمد عبو، وهو من المقربين من الرئيس سعيد، أنه يساند الإجراءات التي أعلن عنها، لكنه يعارض «تعليق العمل بالدستور»، معتبراً أن تونس ستتورط في «انقلاب» إذا حصل ذلك.
كما دعا عبو رئيس الجمهورية إلى عدم الإصغاء لمن وصفهم بـ«المغامرين»، الذين يدعون لذلك، محذراً في نفس الوقت من أي تمديد في الآجال، التي نص عليها الفصل 80 من الدستور، لأن ذلك «يعد أمراً خطيراً… والمجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس».
يذكر أن وزراء خارجية الولايات المتحدة، وعدداً من البلدان الغربية والعربية، وسفراء عدد من العواصم، أجروا خلال الأيام الثلاثة الماضية محادثات هاتفية أو مباشرة مع قيس سعيد ومستشاريه، ومع وزير الخارجية عثمان الجارندي وعدد من القيادات النقابية والسياسية. وأعلن في أعقاب تلك المحادثات عن «استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت».
الشرق الأوسط
——————————-
تونس: أي دور للمؤسسة العسكرية في «الجمهورية الثالثة»؟/ كمال بن يونس
بعد عقود من إبعاد القيادات العسكرية عن مؤسسات صنع القرار السياسي في تونس، ضاعف الرئيس قيس سعيّد دور المؤسسة العسكرية الأمني والسياسي والاجتماعي. وانحازت قيادة الجيش إلى الرئيس سعيّد في معركته مع معارضيه وخصومه داخل الحكومة والبرلمان و«اللوبيات» السياسية والمالية، فدعمت قراره بإسقاط حكومة هشام المشّيشي وتجميد البرلمان.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي كان سياسيون وحقوقيون من عدة تيارات يوجهونها للرئيس سعيّد بسبب ما سموه «إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في خلافات السياسيين»، نجح الرئيس في الحصول على دعم قيادة الجيش للقرارات السياسية غير المسبوقة التي اتخذها يوم 25 يوليو (تموز) والتي وصفها خصومه ومعارضوه بأنها «انقلاب». ومن ثم، يتساءل المتابعون الآن الدور المتوقع للمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة من تاريخ تونس، بعدما أطلق بعض الخبراء عليها تسمية «الجمهورية الثالثة» إيذاناً بطي صفحة «الجمهورية الثانية» ومرحلة حكام ما بعد «ثورة 2011».
خلافاً للتوقعات وللتصريحات القديمة المعارضة لإشراك قيادات الجيش في الحياة السياسية بتونس، تعاقبت خلال الأيام تصريحات التنويه بدعم المؤسسة العسكرية للرئيس قيس سعيّد وقراراته التي تهدف إلى «تصحيح مسار الثورة».
بل إن غالبية الأحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابية، التي وصفت تلك القرارات أول الأمر بـ«الانقلاب على الدستور» و«الانقلاب على نتائج انتخابات 2019»، عدلت خطابها بسرعة، فنوّهت بالمؤسسة العسكرية وحيادية الجيش التونسي منذ تأسيسه عام 1956 عقب استقلال تونس عن فرنسا، وتشكيل الحكومة الوطنية الأولى بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
– مساندة علنية
ولقد تصدّر المرحبون بدعم الجيش لقرارات الرئيس قيس سعيّد، وفي مقدّمها إسقاط الحكومة وتجميد البرلمان «مؤقتاً» عددا من كبار القادة المتقاعدين للمؤسستين العسكرية والأمنية، بينهم الجنرال كمال العكروت المستشار العسكري والأمني للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأمير اللواء محمد المؤدب المدير العام السابق للأمن العسكري وللقمارق (الجمرك)، والعميد مختار بن نصر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب السابق، والعميد هشام المؤدب الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية… الذي عُرف بعد تقاعده بكثرة انتقاداته للرئيس سعيّد وبدفاعه عن مواقف خصومه.
كذلك رحّب عدد من وزراء حكومات الرئيسين السابقين بورقيبة وزين العابدين بن علي، وأيضاً حكومات ما بعد «ثورة 2011»، بينهم أحمد نجيب الشابي ومحسن مرزوق وسلمى اللومي، بقرارات رئيس الجمهورية وبتعاونه مع قيادات المؤسسة العسكرية، وذكّر هؤلاء بحيادها خلال انتفاضة نهاية 2010 ومطلع 2011، وإحجامها عن التورط في قمع المتظاهرين ضد حكم بن علي. وعادت وسائل الإعلام إلى نشر صور تبادل الورود والقبلات في «ثورة 2011» بين الشباب المتظاهر وعدد من الضباط العسكريين التونسيين، والتقاطهم صوراً تذكارية معهم ومع رئيس أركان الجيوش الثلاثة وقتها الجنرال رشيد عمار. وللعلم، كان عدد من كبار السياسيين والقادة العسكريين، بينهم الجنرال عمار، قد صرحوا مرارا بأن قيادة الجيش تلّقت دعوات لتسلم السلطة بعد إسقاط حكم بن علي لكنها رفضت. وما يستحق الإشارة أنه سبق للرئيسين السابقين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي ورؤساء الحكومات المتعاقبون حمادي الجبالي وعلي العريض والمهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد أن أثنوا على «حيادية الجيش» خلال الانتخابات التي نظمت في 2011 و2014 ثم في 2019.
– «الإنقاذ» و«تصحيح المسار»
ومن جهة ثانية، كان لافتاً للانتباه أن أبرز المحللين السياسيين والعسكريين في معظم وسائل الإعلام التونسية قد اصطفوا بسرعة وراء الرئيس سعيّد وقراراته ومشروعه لـ«الإنقاذ» و«تصحيح مسار الثورة» ومحاربة «الفساد المالي» وفتح تحقيق حول مصادر تمويل الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية، وخاصة حزبي «حركة النهضة» (إسلامي) و«قلب تونس» (ليبرالي).
وفي السياق ذاته، نوّه العميد المتقاعد مختار بن نصر الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بكل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو وما بعدها، بما في ذلك عزل رئيس الحكومة وعدد كبير من كبار المسؤولين في الحكومة والقيادات الأمنية والعسكرية. واعتبر بن نصر أن تلك الإجراءات يمكن تفسيرها بـ«شرعيته الانتخابية والسياسية» وصلاحياتها باعتباره رئيساً للدولة وقائداً عاماً للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن إنقاذ البلاد. وتوقع الجنرال بن نصر «تفعيل» كل القرارات التي أصدرها الرئيس سعيّد وسط ترحيب شعبي «لأنه حافظ منذ انتخابه على اجتماعات التشاور والتنسيق مع القيادات العليا للجيش وللمؤسستين الأمنية والعسكرية». بينما اعتبر الجنرال المتقاعد كمال العكروت أن «غالبية الشعب والنخب والقيادات العسكرية والأمنية فرحت بقرارات 25 يوليو، لأنها لم تكن راضية عن التجاذبات السياسية داخل البرلمان والحكومة».
– «خريطة طريق»
في الأثناء تعاقبت الاقتراحات الصادرة عن بعض رموز المؤسستين العسكرية والأمنية، بينهم جنرالات وكوادر في «نقابات الأمنيين». ودعا بعضهم رئيس الجمهورية إلى إعلان «خريطة طريق» تضمن تطبيق قراراته التي تهدف إلى «إنقاذ البلاد من خطر المتطرفين دينياً وسياسياً»، وأن يكون من بين أولوياتها تحقيق الفصل بين السلطات وإرسال رسائل طمأنة الى الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلّق بضمان الحريات والحقوق والمسار الديمقراطي. وكذلك إلى أن يكون رئيس الحكومة الجديد قادراً على تشكيل حكومة أزمة تدير شؤون البلاد وفق برنامج وأهداف واضحة ومدروسة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوبائية، وسط التفشي الكبير لفيروس «كوفيد – 19» في تونس.
هذه التصريحات والمواقف تلتقي كلها مع اقتراحات مماثلة قدمها عدد من كبار الخبراء المدنيين بينهم محمد المنصف شيخ روحه، الخبير الاقتصادي والمالي الدولي ورئيس لجنة المالية في البرلمان سابقاً. إذ شدد شيخ روحه على ضرورة أن «تستفيد الحكومة المقبلة من توصيات الأكاديميين والخبراء وأوساط المال والأعمال بهدف تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة… تؤدي إلى تحسين موارد البلاد وفرص الادخار والاستثمار والشراكة بين المؤسسات المدنية والعسكرية في حفظ الأمن الوطني وتحسين مناخ الأعمال». وفي المقابل، حذر أمير اللواء محمد المؤدب المدير العام للأمن العسكري ولمصالح القمارق من «التسويف» ومن التلكؤ في تفعيل قرارات 25 يوليو. وحث، من ثم، الرئيس على خطوات عملية تشاركية بين العسكريين والمدنيين «للإنقاذ والإصلاح والتصحيح ووضح حد للفوضى وللصراعات بين كبار المسؤولين في الدولة».
– من «التهميش» إلى تصدّر المشهد
في سياق موازٍ، لوحظ أن جلّ بيانات المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب اليسارية والليبرالية الصادرة بعد قرارات 25 يوليو طالبت بـ«احترام الصبغة المدنية للدولة والفصل بين السلطات» وفاءً للمبادئ التي نص عليها دستور الجمهورية الأولى في 1959 ثم دستور الجمهورية الثانية في 2014. إذ صدرت عن منظمات القضاء المدني والمحامين والصحافيين والعمال والفلاحين بلاغات نوّهت بخطوات قيس سعيّد الجديدة، بالتوازي مع تأكيدها على ضرورة «استئناف المؤسسات الديمقراطية» دورها في أقرب وقت، بما يعني رفع التجميد عن البرلمان والمجالس البلدية المنتخبة. وحقاً، تفاعل سعيّد مع هذه المطالب، عندما أعلن في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بممثلي «المجتمع المدني»، وبثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية والتلفزيون التونسي، أنه سيحترم الصبغة المدنية للدولة، والحريات العامة والفردية، ومسار الحوار السياسي مع المعارضين من «دون إقصاء». ونفى أن يكون ما جرى يوم 25 يوليو انقلاباً.
لكن هذه المتغيرات والأحاديث عن «دور أكبر للمؤسسة العسكرية» جاءت بعد سنتين عقد خلالهما قيس سعيّد، بصفته رئيساً للدولة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، اجتماعات بالجملة مع قيادات الجيش والأمن داخل قصر الرئاسة، وفي الثكنات وداخل مقرات وزارتي الداخلية والدفاع.
والجدير بالذكر، أن شعبية سعيّد تزايدت منذ استفحال جائحة «كوفيد – 19» نتيجة إشراكه المؤسسة العسكرية في تطعيم المواطنين في الأرياف والمناطق الفقيرة، وكذلك في إنشاء «مستشفيات عسكرية ميدانية» جديدة في معظم المحافظات بعد تلقي تونس مساعدات كبيرة وصلت إلى البلاد عبر جسور جوية وبرية وبحرية من عدة دول عربية وغربية. وهكذا نجح الرئيس في وضع حد لـ«التهميش» الذي كانت قيادات من الجيش تشكو منه إبان السنوات الـ60 الماضية، تكريسا لمقولة الحبيب بورقيبة «الجيش في ثكناته».
– نعم… ولكن
جدير بالذكر، أن الجيش التونسي نزل إلى الشوارع بكثافة منذ سقوط بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011. ثم تزايد دوره خلال العشرية الماضية بعد تعاقب العمليات الإرهابية في المحافظات الحدودية مع الجزائر وليبيا، ثم داخل العاصمة تونس. ولقد تسببت تلك العمليات في مضاعفة قيمة موازنة وزارتي الدفاع والداخلية 3 مرات مقارنة بموازنات ما قبل ثورة يناير 2011.
وعلى الرغم من تغيير القيادة العليا للجيش مراراً إبان العشرية الماضية، فقد نجح قادتها في لعب دور سياسي مركزي عبر مؤسستي «مجلس الأمن القومي» و«المجلس الأعلى للجيوش» اللتين تضاعف دورهما منذ وصول قيس سعيّد إلى قصر قرطاج الرئاسي بعد انتخابات 2019. ويذكر أن الجيش الوطني التونسي، الذي همش دوره السياسي في عهد الرئيسين بورقيبة (1956 – 1987) وبن علي (نهايات 1987 – يناير 2011) عاد فانخرط بقوة في السياسة الخارجية لتونس خلال السنوات القليلة الماضية عبر إحداث آليات مشتركة مع الجيش الأميركي وقوات عسكرية أوروبية دولية للتنسيق العسكري والأمني حول ملفات لبيبا والجزائر ودول الساحل والصحراء «سين صاد».
– عسكريون في عالم السياسة
وعطفاً على ما تقدم، فإن إشراك القوات المسلحة التونسية في الشأن العام برز منذ أواخر سبعينات وثمانينات القرن الماضي، عندما شهدت تونس أحداثا دامية بمناسبة إضراب عام عن العمل في يناير 1978، ثم بعد مهاجمة مجموعة «كوماندوس» مدعومة من دول مجاورة جنوب تونس خلال يناير 1980 في محاولة للإطاحة بالنظام التونسي.
وفي حينه، لجأ بورقيبة إلى الجيش، وخاصة، إلى الجنرال زين العابدين بن علي، فعينه مديراً عاماً للأمن الوطني، ثم وزيراً للداخلية في أعقاب مظاهرات دامية ضمن ما سُمّي «ثورة الخبز» في أواخر 1983 ومطلع 1984.
منذ تلك الأحداث تضاعفت قيمة الإنفاق العسكري أربع مرات. وعندما قرر الجنرال بن علي والمقربون منه الإطاحة بحكم الحبيب بورقيبة في أواخر 1987، فكّروا في تعطيل العمل بالدستور وتشكيل «لجنة إنقاذ» تضم عسكريين ومدنيين، إلا أنهم سرعان ما عدلوا عن ذلك، وحافظوا على «الصبغة المدنية للدولة» و«النظام الجمهوري».
بعدها، عيّن بن علي في أول عهده بالرئاسة جنرالات في مواقع سياسية عليا، بينهم الحبيب عمار الذي عيّنه وزيراً للداخلية ثم الاتصالات. كذلك عيّن الجنرال عبد الحميد بالشيخ وزيراً للخارجية ثم سفيراً في باريس، والجنرال مصطفى بوعزيز وزيراً للعدل ثم وزيراً لأملاك الدولة.
ثم عين بن علي جنرالات من رئاسة الأركان سفراءً، وأسند لبعضهم رئاسة مؤسسات عليا في الدولة بينها شركات النقل الجوي والحديدي الحكومية. لكنه في المقابل، أبعد غالبية قيادات الجيش عن المسؤوليات السياسية منذ الإعلان عن «محاولة انقلابية» نظمتها ضده مجموعة من العسكريين والأمنيين محسوبة على «حركة النهضة» عام 1992. ولكن، على أي حال، اعتمد بن علي طوال حكمه على عسكريين كبار في بعض المهمات الاستراتيجية مثل الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الرئاسي اللتين تداول عليهما طوال 23 سنة الجنرال علي السرياطي.
مع هذا، شاءت الأقدار أن يتهم السرياطي، مطلع 2011، بأنه لعب دوراً مهماً في الإطاحة بحكم بن علي لأسباب عديدة من بينها الصراعات التي انفجرت داخل مؤسسات الحكم عموماً، ومنها الصراع بينه وبين قيادات الجيش في وزارة الدفاع الوطني بزعامة الجنرال رشيد عمار رئيس أركان جيش البر، والجنرال أحمد شبير رئيس المخابرات العسكرية.
– الورقة الدولية
إلا أن المتغيرات في المشهد السياسي ودور المؤسسة العسكرية في تونس من الأمور التي ستبقى رهينة عوامل كثيرة، من بينها تطورات مواقف الدول المؤثرة في القرار السياسي والعسكري في تونس، وعلى رأسها الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
كذلك ستتأثر، حتماً، بطبيعة الحكومة الجديدة وشخصية رئيسها والمشرفين على وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية. ولا سيما، إذ ما كانوا سيُختارون من المدنيين والحقوقيين – مثل معظم وزراء الحكومتين السابقتين -، أم سيكون بينهم عدد من الضباط العسكريين والأمنيين.
وفي هذه الحالة، وتلك، ستتأثر مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة والمواقف من دور المؤسسة العسكرية بنتيجة مشاورات «الكواليس» بحثاً عن اتفاق سياسي يضمن استئناف البرلمان والمجالس البلدية وكل المؤسسات المنتخبة لمهامها، في ظرف شهر أو اثنين. وهذا أمر حيوي كي لا تتدهور الأوضاع الأمنية فيها خلال مرحلة زمنية تتعثر فيها مسارات التسوية السلمية لأزمة ليبيا لأسباب عديدة من بينها «لعبة المحاور الإقليمية والدولية».
– الجيش التونسي اقتحم تجربة التصنيع الحربي
> طوّر الجيش التونسي بعد ثورة 2011 قدراته العلمية واللوجيستية وخبرته في التصنيع والحرب بالشراكة مع جيوش عدد من دول الحلف الأطلسي «ناتو»، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا. ولقد زار الرئيس قيس سعيّد يرافقه وزير الدفاع وكوادر عسكرية مؤسسة نجحت في إنتاج آليات عسكرية متوسطة بقدرات وطنية. وكشفت مصادر من وزارة الدفاع الوطني التونسي، خلال جلسة استماع سابقة أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان، أن «القوات العسكرية التونسية، نجحت في صناعة عربة عسكرية، تخطت مختلف التجارب».
أيضاً، كشف وزير الدفاع المعزول مؤخرا عن أن «القوات التونسية، دخلت أيضاً مجال التصنيع البحري وصنعت ثلاث قطع بحرية، وأصبح بالإمكان تجهيزها بالأسلحة ووسائل الاستطلاع والاستعلام، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص». وأضاف قائلاً إن «وزارة الدفاع تنوي المضي قدماً في هذا المجال بتصنيع وحدات بحرية أخرى».
هذا، وجاء خوض المؤسسة العسكرية مغامرة التصنيع العسكري بهدف «الضغط على الكلفة»، حيث تشير الإحصاءات إلى توفير مبالغ مالية كبيرة، وخلق فرص عمل للشباب ومن بينهم أصحاب الشهادات العليا في اختصاصات عدة، وتثمين التكوين العسكري، الذي يتلقاه الضباط في الداخل والخارج، واكتساب الخبرة في مجال التصنيع العسكري في مختلف وحدات الجيش. حسب وزير الدفاع السابق.
وخلال مايو (أيار) 2015 كانت قد نُظمت تظاهرة وطنية عُرضت فيها معدات صنعتها كفاءات تونسية، من بينها طائرة من دون طيار جُربت لأول مرة في عام 2013. ويبلغ طول هذه الطائرة ثلاثة أمتار، ووزنها 45 كيلوغراماً، وهي قادرة على بلوغ ارتفاع يصل إلى 2500 متر، وكما تصل مدة تحليقها إلى ثلاث ساعات.
أيضاً، عُرضت عينات أخرى من أجهزة تشغيل وتحطيم الألغام، وكُشف الستار عن رجل آلي مسلح مختص في القتال والتمشيط والاستطلاع وكشف الألغام، بالإضافة إلى منظومة لمتابعة التشكيلات العسكرية على الميدان في المهمات العملياتية، ورادار لكشف التحركات وأجهزة لاسلكية. وكل هذه مشاريع رائدة من شأنها أن تعزز قدرات الجيش التونسي على مجابهة مختلف التحديات الداخلية والإقليمية.
الشرق الاوسط
————————
هل يتراجع سعيّد عن انقلابه على الديمقراطية؟/ زهير إسماعيل
لم يكن الاختلاف حول طبيعة ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد يوم عيد الجمهوريّة أمرًا جديًّا أمام إجماع الأحزاب الديمقراطيّة ومنظّمات المجتمع المدني ومراجع القانون الدستوريّ والجمعيّات والهيئات القضائيّة الدستوريّة والتعديليّة على أنّ الإجراءات المُعلنة انقلابٌ على الدستور والديمقراطيّة ومؤسسات الدولة المنتخبة. ولم تكن كلمته أمام أهمّ المنظّمات الاجتماعيّة إلاّ تبريرًا لمغامرة قد تذهب بالدولة ومؤسساتها وتعصف بالسلم الأهلي.
مقدّمات الانقلاب
كثيرًا ما يُتغافل عن أنّ المنظومة الديمقراطيّة التي استهدفها الرئيس قيس سعيّد بإجراءاته الأخيرة هي التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة. وهو أكثر من يَشهد بأنّه آتٍ من خارج الدوائر المناهضة الاستبداد والدفاع عن الحريّات السياسيّة العامّة والفرديّة. وكان من كرم الثورة أن وزّعت السلطة أفقيّا حتّى اعتلى أعلى المناصب أبناءُ الداخل المهّمش والأعماق المنسيّة. ولا يفسّر هذا السخاء السياسي سوى بحث الدولة الحثيث عن قاعدة حكم متينة تستقرّ عندها في هيئتها الجديدة بعد أن حرّك زلزال الانتفاض الاجتماعي المواطني طبقات الأبنية الاجتماعيّة والتضامنات السائدة وشبكات المصالح المتوارثة، على أمل أن يكون توزّع السلطة الأفقي مقدّمة إلى توزيع أعدل للثروة وجودة العيش.
لم يُخف قيس سعيّد اختلافه مع الديمقراطيّة التمثيليّة ولكنّه قَبل بأن يترشّح إلى منصب رئاسة الجمهوريّة ضمن منظومتها التي بنتها الثورة، وأقسم أمام مجلس نواب الشعب على صيانة دستورها واحترامه. ونُظر إلى هذا الاختلاف على أنّه ممّا تستوعبه الديمقراطيّة باعتبارها اختيارًا شعبيًّا عامًّا وحرًّا. فمن كرم الديمقراطيّة وشجاعتها إتاحتُها الفرصة لمناهضيها مع اشتراطها بأن يكون تجاوزها بوسائل ديمقراطيّة. وعندما عاد قيس سعيّد، بعد أن أصبح رئيسًا للجمهوريّة، إلى التذكير بأطروحته الشكلانيّة في الانتظام السياسي الأفقي، لم يكن من اعتراض من النخبة الديمقراطيّة على ما يعرضه سوى التزامه بما تمّ التعاقد عليه في دستور الثورة واحترام ما انبنى من مؤسسات ديمقراطيّة على ضوئه.
لم يمرّ وقت طويل حتّى بدأ توتّر رئيس الجمهوريّة المحسوب على الصف الثوري مع مؤسسات النظام السياسي سليل دستور الثورة. وقابله توتّر آخر أشدّ في مجلس النوّاب في أولى جلساته تطوّر إلى بلطجة متواصلة من قبل نوّاب الدستوري ممثّل التجمّع المنحلّ عطّلت أشغال المجلس ورذّلت دوره. وبدا واضحًا أنّ نتائج انتخابات 2019 في حاجة إلى قراءة جديدة بعيدًا عن الانطباعات الأولى التي اعتبرتها جولة لفائدة القوى المنتصرة للثورة، بعد أن كانت انتخابات 2014 جولة لصالح القديم. وأمكن ملاحظة انحدار في المشهد السياسي العام من جهة انحسار شروط بناء الديمقراطيّة وتواصل مسارها.
فبعد أن كان الإجماع على مفهوم الدولة، ولقاء بين القديم والجديد وسط العمليّة السياسيّة، ووجود مؤسسة أمنيّة وعسكريّة خارج رهانات السياسة ومغانمها شروط تواصل الانتقال إلى الديمقراطيّة أفصحت انتخابات 2019 عن مشهد جديد. ويتلخّص هذا المشهد في صعود الأطراف (الكرامة/عبير) وضعف الوسط (النهضة) واضمحلال أحد اطرافه (نداء تونس) وظهور منزع شعبوي يغلب عليه الغموض (قيس سعيّد).
تدرّج الانقلاب
لم يكن من الطبقة السياسيّة انتباه إلى هذا التحوّل في المشهد السياسي وقواه الفاعلة. ومع حكومة المشيشي بدأت ملامح المشهد تكتمل. وظهر إلى جانب “الصراع الديمقراطي”. وهو نتيجة لأطوار تدافع القديم والجديد على قاعدة توافق بشروط القديم الفائز بانتخابات 2014 وتحت سقف المنظومة الديمقراطيّة التي بناها الجديد. ومثّل قيس سعيّد وعبير موسي هذا العنوان الجديد من الصراع المستهدف للديمقراطيّة من داخل مؤسساتها (الرئاسة، البرلمان).
في أوّل الأمر كان سعيّد محسوبًا على الجديد والصفّ الثوري رغم اختلافه النوعي عنه، مثلما كانت موسي محسوبة على القديم رغم اختلافها عن أهمّ مكوّناته نداء تونس المضمحل. ومع ذلك فإنّهما يتقاطعان في مناهضة المنظومة الديمقراطيّة في نموذجها التمثيلي باعتباره شكل انتظام تقليدي عمودي يسمح بإعادة إنتاج علاقات القوّة بعيدًا عن العدل والمشاركة المباشرة للفرد عند سعيّد، وباعتباره انقلابًا على نموذج الدولة الوطنيّة والمشروع السياسي البورقيبي عند موسي.
كانت بداية حرب الرئيس قيس سعيّد على الدستور ومرجعيّة الديمقراطيّة ومسارها. فالدستور بالنسبة إليه نصّ انبنى على ترضيات هوويّة وفئويّة طبعته بالتضارب ومن ثمّ بالتهافت. وكان لهذه التجاذبات التي نشأ فيها أثر مباشر على النظام السياسي شبه البرلماني الذي تضمّنه. وما يميّز هذا النظام من تعدّد رؤوس الدولة برغبة تجنّب مركزة السلطة في يد جهة واحدة.
سعيّد الذي كان بالأمس من بين خبراء القانون الدستوري الذين شاركوا في صياغة الدستور في لجان المجلس الوطني التأسيسي هو اليوم يناهض الدستور، بعد أن أقسم على احترامه والوقوف عند أحكامه.
أدّى هذا التجاذب السياسي في أعلى مؤسسات الدولة إلى شلل نصفي في الحكومة فصارت تعمل بنصف وزرائها حين تعطّل التحوير الوزاري . وإلى تعطّل متواصل لمؤسسة البرلمان. وكان لكلّ هذا انعكاس مباشر على الحياة الاجتماعيّة وتفاقم الأزمة المركّبة. ولعلّ أخطر النتائج كان فيما صاحب التجاذب الذي لا يتوقّف في مؤسسات الدولة الأولى من ترذيل للديمقراطيّة ويأس عام من السياسة. وبذلك اجتمعت أسباب الاحتقان والإحباط المجال الخصب لتوسّع المنزع الشعبوي وترسّخ الحاجة إلى الزعيم المنقذ.
فالانقلاب على الدستور والديمقراطيّة بدأ عمليّة متدرّجة اشتغلت على شلّ المؤسسات والحياة السياسيّة ومفاقمة الأزمة وتيئيس منهجي من جدوى الديمقراطيّة وقدرتها على بسط الرفاه والأمن والعيش المشترك.
ومثّل تاريخ 25 يونيو درجة تأزيم قصوى كانت مبرّرًا كافيًا لإعلان الانقلاب على الدستور والديمقراطيّة.
صور من الانقلاب
مضى على الانقلاب أربعة أيّام. ومن المهمّ الوقوف عند ردود الأفعال. وهي ردود أفعال متداخلة متخارجة تعكس حجم الانقسامات التي شقّت المشهد السياسي. وكان موقف النهضة الأبرز والأكثر شدًّا للأنظار لما بلغته علاقة التوتّر بين الرئيس سعيّد وحركة النهضة، وبسبب ترؤّس حركة النهضة لمجلس نواب الشعب. وكانت أكثر الصور بلاغة وأثرًا صورة رئيس مجلس نواب الشعب الرجل الثمانيني مصوحبًا بنائبته الأولى وهو يقف أمام باب البرلمان الموصد، وخلف قضبان بوابته الضخمة تجثم مدرّعة عسكريّة لتنبّه إلى أنّ البرلمان موصد بأمر من رئاسة الجمهوريّة.
وبدا التحاق نوّاب وأنصار من حركة النهضة بالبرلمان مؤذنًا برفض قاطع لعمليّة الانقلاب على الديمقراطيّة ويمثّل البرلمان مؤسستها الأصليّة.
وتتالت الردود من الأحزاب والجمعيّات والمنظّمات ومن الهيئات القضائيّة والدستوريّة والتعديليّة وكانت في أغلبيّتها الساحقة رافضة للإجراءات الاستثنائيّة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، وداعية إلى احترام دستور الثورة.
وفي سياق ردود الأفعال هذه يفهم لقاء قيس سعيّد مع أهمّ المنظّمات الاجتماعيّة. وبدا في كلمته إلى ضيوفه مبرّرًا تبرير المتراجع. فالمنقلب الفعلي لا يجعل من انقلابه موضوعًا للنقاش بقدرما يمرّ إلى تنفيد ما أعلن عنه. ولا خلاف في كون الرئيس قيس سعيّد كان يستهدف جهتين باحتجاجه على أنّ ما أتاه لا يخرج عن الدستور والفصل 80. الجهة الأولى هي المشهد السياسي التونسي وقواه السياسيّة والاجتماعيّة الفاعلة. ولن يكون مرتاحًا إلى وصف حركته بالانقلاب. ولكنّه يدرك أنّ عهودًا من نضال النخبة ضدّ الاستبداد ومن استماتتها من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحياة السياسيّة الديمقراطيّة والمشاركة في بناء تونس الجديدة ستكون حواجز عالية في طريقه إلى تصفية الديمقراطيّة التمثيليّة وفرض نموذجه الشكلاني الغامض.
والجهة الثانية هي القوى الإقليميّة والدوليّة صاحبة المصالح في تونس والمنطقة. ولا يخفى أنّ تونس تمثّل
نقطة تماسّ بين أبرز المحاور المتصارعة على منطقة المتوسّط والساحل والصحراء. وهي نقطة تتقاطع عندها مواقف هذه القوى من مسار بناء الديمقراطيّة في المجال العربي والتجربة التونسيّة باعتبارها تجربة الانتقال إلى الديمقراطيّة الوحيدة المتواصلة.
أفق الانقلاب
اعتُبر سحب النهضة لأنصارها من البرلمان تجنّبًا للمواجهة وإيثارًا للحوار طريقًا إلى التراجع عن الإجراءات الاستثنائيّة. غير أنّ الدلالة السياسيّة الأبرز لهذا الموقف هو أنّ المواجهة ليست بين سعيّد والنهضة ولا بين النهضة والشعب مثلما نجحت نسبيًّا تظاهرات 25 جويلية في إظهاره، بقدرما هو مواجهة بين الانقلاب والديمقراطيّة. وقد كان من نتائج سياسة التعفين والعجز عن الأدنى من المنجز الاجتماعي والصراع في أعلى مؤسسات الدولة استعداد طيف واسع من الناس للقبول بالانقلاب على فشل حكومة المشيشي التي تُنسب إلى النهضة دون أن تشارك فيها.
منذ إعلانه عن الإجراءات الاستثنائيّة لم يكن من سعيّد إجراءات تذكر سوى بعض الاجتماعات هنا وهناك وتبدو موجّهة أكثر إلى جمهور قيس سعيّد المدعوم بجيوش إلكترونيّة ضخمة تثير كثيرًا من الأسئلة. فجمهور سعيّد مطالب بمحاسبة الفاسدين الذين لا تخلو منهم كلمة من كلماته. ومصرّ على تجاوز المنظومة الديمقراطيّة، فهي بالنسبة إليه سبب الأزمة.
تعرف تونس منعرجًا خطيرًا يهدّد تجربتها في الانتقال الديمقراطي في ظلّ أزمة خانقة وعجز عن التجاوز لا يمكن أن يفرزا سوى نزعات شعبويّة مجنونة يسهل توظيفها في هدم محاولات تأسيس الحريّة والمواطنة من قبل قوى إقليميّة ودوليّة لا تخفي عداءها للربيع والحريّة. ولئن كان الذي يحدث في تونس يجد أسبابه في السياق التونسي إلاّ أنّه لم يكن بعيدًا عن أجندات معادية للحريّة والديمقراطيّة بقيادة الإمارات ومصر ودولة الكيان.
لم يتّخذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات كبرى منتظرة، ويبدو أنّ ما صرّح به أمام منظّمة الأعراف تغييره للرئيس المدير العام بالتلفزة الوطنيّة يأتي في إطار تأكيد الحضور لجمهوره ولكلّ من له أمل في أن يقوم سعيّد بإصلاحات جوهريّة لصالح الفقراء والمهمّشين وما وعد به من حرب على الفساد.
هذه المرّة ستكون الشروط الدوليّة هي العامل الحاسم في مستقبل تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الإجراءات الاستثنائيّة التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد. وقد أجمعت الطبقة السياسيّة والديمقراطيّة على خروجها عن الدستور وأنّ الحوار بمرجعيّة الدستور والديمقراطيّة هو السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها.
تبدو تجربة بناء الديمقراطيّة في تونس غير قابلة للكسر، بالنظر إلى النخبة السياسيّة وتاريخ الدولة وإلى عشر سنوات من الحياة السياسيّة الديمقراطيّة، وأخيرًا إلى توازنات المحاور والرهانات الإقليميّة والدوليّة الراهنة.
الترا صوت
————————
“تصحيح للمسار” و”إنقاذ للبلاد”… خطوات قيس سعيّد بعيون مؤيديه/ منيرة حجلاوي
مساء الأحد، في 25 تموز/ يوليو 2021، شهدت شوارع العاصمة تونس احتفالات كبيرة تواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل، إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ “تدابير استثنائية” جمّد بموجبها البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن كافة نوابه وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
تعالت الهتافات والزغاريد في صفوف المحتفلين على طول شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وأُطلقت الألعاب النارية رغم فرض السلطات التونسية حظراً للتجوّل بسبب تفشي وباء كورونا، كما عمّت أجواء الفرح كافة مناطق البلاد وخرجت إلى الشوارع أعداد كبيرة من أنصار سعيّد، من مختلف الفئات العمرية، لتؤكد دعمها المطلق له.
كانت أمل بوعلي من بين الذين احتفوا بقرارات الرئيس التونسي. لم تخفِ سعادتها “بتحقيق سعيّد إرادة الشعب بتجميده برلمان الفضيحة والعار وبمعارضته حركة النهضة وعمله على إزاحتها ومقاومته للفساد”، حسبما تقول لرصيف22.
وتضيف الشابة التي تعمل مستشارة في بلدية أن سعادتها اكتملت بإنهاء سعيّد مهام المشيشي الذي “لم يقنعني كرئيس حكومة وكان دون المستوى في جميع اختياراته”، وتتابع: “الآن فقط، أشعر أنه لدينا رئيس دولة. لم أصوّت لسعيّد ولكنّي الآن أدعمه، وفي الآخر كلهم راحلون من سعيّد إلى (زعيم حركة النهضة) راشد الغنوشي وغيرهم وستبقى تونس فقط”.
بدوره، يشير كاتب روايات الجيْب التونسية الشاب عاطف حاتمي إلى أنه سُرّ بخطوات الرئيس لأن “الفساد نخر البلاد في جميع القطاعات بينما لا يولي السياسيون، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، أية أهمية لمصلحة الوطن”.
ويضيف لرصيف22 أن هذه الإجراءات تأخرت وأن أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تعد تحتمل مزيداً من الصمت، لافتاً إلى ضرورة اتّباع رئيس الجمهورية خارطة طريق تضمن “عدم عودتنا إلى الوراء”.
أمر واقع
يعلّق الناشط الحقوقي ناصر هاني على ردة الفعل الشعبية لدى شرائح واسعة من المجتمع التي عبّرت عن ارتياحها بقرارات الرئيس بقوله لرصيف22: “الاحتفالات أمر واقع ويجب البحث في أسباب تغذية هذا الشعور الشعبي الرافض لنتائج الثورة والصندوق”.
وأصدر سعيّد أيضاً يوم الاثنين، في 26 تموز/ يوليو أمراً رئاسياً يقضي بمنع تجوّل الأشخاص والعربات على كامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً، لغاية 27 آب/ أغسطس.
كما أصدر يوم الخميس، في 29 تموز/ يوليو، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وفور إعلانه التدابير الاستثنائية، أعلنت كتل برلمانية وأحزاب سياسية معارضتها لما أسمته “انقلاب” سعيّد على الدستور لتتراجع لاحقاً بعض هذه الأطراف وتساندها، فيما أعلنت أخرى منذ البداية دعمها لما اعتبرته “تصحيح المسار”.
ومن بين المعارضين حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، صاحبة الأغلبية البرلمانية بـ53 مقعداً، وكتلة حزب ائتلاف الكرامة ذات التوجه الإسلامي والتي يرأسها سيف الدين مخلوف وتمتلك 18 مقعداً نيابياً، إضافة إلى حزب العمال اليساري غير الممثل في البرلمان والذي يرأسه حمه الهمامي.
وتضم الكتل المساندة لقرارات سعيّد أو غير المعارضة مبدئياً لها الكتلة الديمقراطية صاحبة 38 مقعداً نيابياً، وهي تشمل كلاً من حزب التيار الديمقراطي ذي التوجه الديمقراطي الاجتماعي ويتولى أمانته العامة غازي الشواشي، وحركة الشعب ذات التوجه الناصري ويتولى أمانتها العامة زهير المغزاوي، وكتلة حزب قلب تونس ذات التوجه العلماني والتي تمتلك 28 مقعداً نيابياً ويرأسها نبيل القروي، حليف النهضة، والذي تراجع عن موقفه الرافض لقرارات سعيّد في البداية.
كما تضم قائمة المؤيدين حزب تحيا تونس، وهو حزب بتوجّه بورقيبي علماني ويرأسه يوسف الشاهد ويمتلك 10 مقاعد نيابية، والحزب الجمهوري غير الممثل في البرلمان، وتوجهه وسطي اجتماعي معتدل ويتولى أمانته العامة عصام الشابي، وحزب مشروع تونس غير الممثل في البرلمان وتوجهه ليبرالي تقدمي ويرأسه محسن مرزوق، وحركة تونس إلى الأمام غير الممثلة في البرلمان ويتولى أمانتها العامة عبيد البريكي.
“تعفّن المسار”
يقول النائب عن التيار الديمقراطي زياد غناي إن حزبه يساند سعيّد بسبب “تعفّن وتوقّف المسار الذي شهد عدة إشكالات في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ما أدى إلى حالة احتقان اجتماعي تجلّت بخروج التونسيين في تظاهرات وتحميلهم المسؤولية للأطراف السياسية وخاصة لحركة النهضة التي تحكم تونس منذ عشر سنوات”.
ويضيف لرصيف22 أن التيار “يتفهم إجراءات الرئيس الدستورية ويتفهم السياق والطريقة اللذين أتت فيهما حتى تساهم في تصحيح المسار بقواعد العمل الديمقراطي الفعلي وليس بديمقراطية صُوَرية”.
وأوضح غناي أن حزبه سيقدّم جملة من المقترحات ويبدي رأيه في خارطة الطريق التي يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لاقتراحها على سعيّد وسيراقب مدى عودة المؤسسات إلى سيرها الطبيعي وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة تفتح على مشهد جديد.
ووفق غناي، فإن “السياسة لا تقوم على تكهنات والرئيس بيّن على مستوى خطابه أنه يريد الإصلاح من داخل الدولة وبأجهزتها وباحترام القانون وعلوية الدستور”، مشدداً على تمسك حزبه بـ”مبادئ احترام الحريات والديمقراطية والتعددية وبمشهد سياسي خالٍ من الزبائنية والفساد”.
“تقييم صائب”
من جهته، يرى القيادي في حركة الشعب محسن عرفاوي أن إجراءات سعيّد تدخل في إطار “الخطر الداهم” ويشير إلى أنها كانت منتظرة بعد تفشي ظاهرة العنف في البرلمان وانتشار الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بحلّه مع سوء تصرف الحكومة إزاء الوضع الصحي المتأزم وفقدان عشرات آلاف الوظائف وممارسات الحزام البرلماني من حركة النهضة وحلفائها داخل البرلمان بتمرير قوانين بالقوة لا علاقة لها بمشاغل الشعب.
ويصف تقييم سعيّد للأوضاع بـ”الصائب” مؤكداً أنه “لو لم يتدخل لحدث انفجار شعبي كبير سيعصف بالجميع”.
ويشدد على ثقة حركته في عدم تنكر سعيّد لمكسب مسار الانتقال الديمقراطي ويضيف لرصيف22 أنهم ينتظرون منه المحافظة عليه وعلى الحقوق والحريات والمضي نحو حلول اقتصادية واجتماعية فورية.
كما تنتظر الحركة من سعيّد محاسبة النواب والسياسيين والأحزاب الذين ارتبطت بهم قضايا فساد وفتح ملفات الاغتيالات السياسية “وهو مطلب شعبي سيغيّر المشهد داخل البرلمان المرتقب”، مرجحاً إمكانية إجراء انتخابات جزئية وتعيين رئيس حكومة لتسيير المرحلة الانتقالية “الخطيرة” والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وبحسب عرفاوي، فإن حركته ستكون معارضاً شرساً للرئيس “في حال تراجعه عن مسار الانتقال الديمقراطي وعدم تطبيق وعوده وتحويلها إلى واقع ملموس”.
“منزلق خطير”
من جانبه، يُرجع القيادي في الحزب الجمهوري وسام الصغير تأييد حزبه للتدابير الاستثنائية إلى “سقوط تونس في منزلق خطير جداً يهدد المرحلة الانتقالية التي أنقذها سعيّد، وهي خطوة بمثابة الطور الثاني من المسار الثوري الذي سيمكننا من استرداد الوطن من عصابات ولوبيات كانت لديها سلطة على الدولة باعتماد أذرع سياسية وهي منظومة الحكم”.
ويقول الصغير لرصيف22 إن تأكيدات رئيس الجمهورية المتكررة على تحركه في إطار الدستور وتمسكه به ولقاءاته مع المنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية بهذا الخصوص، دلالة على احترامه للدستور، آملاً في أن تكون المرحلة الانتقالية الجديدة كما وعد بها سعيّد قائمة على “محاسبة كل المذنبين وعلى العودة إلى طريق الديمقراطية الصحيح بتصفية موروث السنوات العشر الأخيرة مع ضرورة تشكيل حكومة جديدة”.
وشدد على أن مساندة حزبه “ليست صكاً على بياض” وأنهم سيراقبون ويتابعون “إن أحسن الرئيس الاختيار أم لا، وحينها سنتصدى له بصدور عارية”.
“حالة ارتياح”
بدورها، توضح عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس أن الجمعية تتفهم أن “وضعية البلاد التي تشهد منعرجاً خطيراً من تعفن الوضع السياسي وتردي المشهد البرلماني وتهاوي مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة الصحية خلقت حالة من الارتياح لدى الشارع التونسي تجاه قرارات سعيّد ويهم الجمعية أن تكون دائماً في صف تطلعات الشعب التونسي”.
وتقول لرصيف22 إنه حتى وإنْ “برر التلاعب بالديمقراطية والأزمة المحتدمة بين مؤسسات الدولة والاستشراء المخيف للفساد في كل مفاصل الدولة وثقافة الغنيمة والزبائنية هذه التدابير الاستثنائية، إلا أنه علينا العودة إلى الحالة الديمقراطية”.
وتؤكد فراوس ضرورة المرور إلى منظومة المحاسبة والمساءلة في كل نواحي الفساد وتقديم الضمانات التي تبيّن أن هذه الحالة الاستثنائية ستحوّل البلاد إلى حالة ديمقراطية، وتعتبر أن “رئيس الجمهورية بالفعل مضطر لها من أجل ما هو أفضل”.
وترى أن البلاد حالياً في “حالة استثنائية دكتاتورية مؤقتة لأنها فوّضت للرئيس جمع كل الصلاحيات لديه”، معتبرة أن سعيّد لم يكن مطمئناً دائماً في علاقته بحقوق النساء والحريات العامة والفردية.
وأشارت إلى أن ما سيحدث مستقبلاً مفتوح على كل الإمكانيات، مستدركة: “ولكن نعتبر أن لتونس تقاليد في حقن الدماء في كل الأحداث التي تمر بها وفي إيجاد حلول للخروج من الأزمات السياسية ولديها مقومات تواصل الدولة المدنية واستمرار الإدارة”.
وشددت على ضرورة وجود إطار للتشاور والحوار حول خارطة الطريق ليتم تقييد وتحديد الحكم المطلق والفردي لرئيس الجمهورية “وليس بالضرورة أن يكون إطار الحوار الوطني مع الفاعلين السياسيين الذين تسببوا في هذه الأزمة السياسية بل يجب أن يكون مع الأطراف التي قاومت المنظومة على مدى عشر سنوات”.
“مساندة مشروطة”
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن مساندته “المشروطة” لقرارات سعيّد. ويعزو الكاتب الصحافي صبري الزغيدي اتخاذ الاتحاد لهذا الموقف إلى “ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية نتيجة لحكم حركة النهضة لأكثر من عشر سنوات والذي لم يأتِ على البلاد إلا بالخراب والاغتيالات السياسية”.
كما يعزوه إلى ترحيب فئات واسعة من المجتمع بهذه الإجراءات باعتبارها تعكس مشاغله وهمومه وغضبه من برلمان لم يكن في مستوى تطلعات الشعب وكان مسرحاً للعنف وبات “مؤسسة متخلفة”، ومن مؤسسة رئاسة الحكومة التي لم يكن لها أي برنامج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وزاد فشلها في التعاطي مع أزمة كورونا تعميق للأزمة، إضافة إلى اهتراء المقدرة الشرائية والزيادة المهولة في الأسعار.
ويوضح الزغيدي لرصيف22 أن تشخيص الاتحاد صاحبته شروط المرافقة بضمانات دستورية في أن تكون للحكومة الجديدة برئيسها الجديد خطة واضحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأن تتابع بنشاط ملفات الفساد ونهب المال العام والتهرب الضريبي.
وكشف عن استعداد اتحاد الشغل لإصدار خارطة طريق تكون مراكمة لقرارات الرئيس الأخيرة تطرح مشاغل الشعب التونسي في العيش الكريم ومقاومة الوباء وتطرح “الملفات المقبورة على مستوى القضاء وعلى رأسها قضية الاغتيالات السياسية”، ثم المرور إلى مراجعة المنظومتين السياسية والانتخابية في اتجاه نظام سياسي مستقر.
وشدد من جهة ثانية على أن الاتحاد سيكون “معارضاً شرساً لقيس سعيّد إذا واصل بشكل مبالغ فيه تجميع السلطات لديه وتجاهل التزاماته في طرح ملف الفساد والتمويل المشبوه للأحزاب وضرب وانتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكاسب الشغلية والسيادة الوطنية ورَهَنَ القرار الوطني”.
“ليست كافية”
وعبّرت عدة شخصيات مستقلة عن دعمها لخطوات سعيّد، من بينها الدبلوماسي وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس الذي رأي أنه “ومهما كانت قرارات الرئيس جريئة ولكنها كانت ضرورية من المنطق السياسي لأنها تضع حداً لأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية لا تطاق طالت في الزمن وتشعبت وأصبحت تعجّز نشاط أركان الدولة”.
ويوضح ونيس لرصيف22 أن قرارات رئيس الجمهورية “ليست كافية لأنها يمكن أن تؤثر بصفة خطيرة على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والصحافة”.
وطالب المتحدث سعيّد بالإسراع في تعيين حكومة كاملة تتولى مهام الإشراف على الوزارات للتخفيف على رئيس الجمهورية عبء مسؤولية الدولة وحتى لا تبقى السلطات محصورة في شخص واحد “ما يمثل خطراً على الدولة”.
وبخصوص ما تحمله الأيام القادمة لتونس، توقع إمكانية استعمال أركان الدولة التي وقع تعجيزها (برلمان وحكومة) سلطتها لتهييج الشارع التونسي للتصدي لإجراءات سعيّد “وستكون حينها منطلقاً لحرب أهلية”، ودعا الرئيس إلى إيجاد سبيل للخروج من استهداف حزب حركة النهضة “الشرعي القادر على تهييج أنصاره” بطريقة سياسية سلمية حتى “لا تلتهم حرائق الغابات ضمائر التونسيين”.
وأشار إلى أنه وكافة التونسيين سيقفون بالمرصاد لسعيّد في حال “علّق الحريات وقام بحملات ضد المعارضين المطالبين باحترام قواعد الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة”.
أما النائب المستقل حاتم المليكي، فيقول لرصيف22 إن الفصل 80 من الدستور يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ هذه التدابير الاستثنائية نظراً “لوجود خطر داهم” يتجلى في خلاف رئاستيْ الحكومة والبرلمان الحاد مع رئاسة الجمهورية وفشلهما الذريع في إدارة أزمة جائحة كورونا إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة “ما استوجب تدخل سعيّد لإنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها”.
ودعا المليكي قيس سعيّد في المقابل إلى التسريع في تشكيل حكومة جديدة وترجمة إجراءاته على أرض الواقع، كاشفاً أنه لن يكون في صفه في حال تعليقه العمل بالدستور ومساسه بالحقوق والحريات وتخليه عن المؤسسات الدستورية.
رصيف 22
—————————–
القبضة تشتد في تونس… اعتقالات ومحاكمات عسكرية ومنع تظاهرات
في تصعيد جديد، اعتقلت قوات الأمن التونسية أمس، 30 تموز/يوليو، نائباً في البرلمان ندد بـ”استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة” ووصف قراراته الأخيرة بأنها “انقلاب عسكري”.
وأعلنت حركة أمل وعمل التي يترأسها النائب ياسين العياري خطف النائب بالبرلمان التونسي من منزله بعد اقتحام ستة عناصر أمنية في ملابس مدنية بيته من دون إذن قضائي، ورفضهم الإدلاء بأية معلومات عن الجهة الأمنية التي يتبعونها، مكتفين بالقول إنهم “أمن رئاسي”، بعدما أجبروه على الخروج من منزله وأدخلوه عنوة في إحدى السيارات الأمنية التي كانت تقف أمام المنزل.
وقال محاميه مختار الجماعي إن مجموعة تتكون من 30 عنصراً حضرت بالزي المدني إلى منزل موكله، معززة بـ10 سيارات. وقدّمت نفسها على أنها من الأمن الرئاسي، مشدداً على أن الموضوع يتعلق بـ”تصفية خصوم سياسيين”، وفق تعبيره.
وذكرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس أنه جرى إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس، لتنفيذ حكم صدر من محكمة عسكرية بالسجن لمدة شهرين على خلفية “المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته”.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أعربت فيه عن قلقها من استهداف المعارضين التونسيين بالمحاكمات العسكرية التي تنتهك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو المثول أمام قاضيه الطبيعي. كما أدانت محاكمة الأفراد على آرائهم السياسية.
وفي وقت لاحق أعلنت وسائل إعلام تونسية اعتقال ماهر زيد، النائب عن حزب الكرامة المعارض لقيس سعيد، “بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه لصالح المحكمة الابتدائية بمنوبة”.
وسخرت المحامية التونسية إيناس حراث من اعتقاله، وقالت إنها جاءت بناء على قضية تم تسويتها عام 2018، مضيفة “هل هذا أقصى ما وجده الانقلاب ضد النواب؟ يا فضيحتكم”.
وقالت حراث: “بالرغم من استظهارنا بكف (بيان) التفتيش (الملاحقة)، النيابة العمومية تنكل بماهر زيد وترفض الإفراج عنه”. وتابعت: “في تونس فقط قد يصدر في شأنك حكم في قضية وتسوي وضعيتك أمام العدالة وتبقى مع ذلك مفتشاً عنك”.
وفي مقطع فيديو، أعلن زيد أن المحكمة قررت إطلاق سراحه، لكن فرقة أمنية تريد اعتقاله من دون إذن قضائي. وقال إنه مضرب عن الطعام احتجاجاً على ملاحقته.
وأعلن النائب زياد الهاشمي إيقاف المدون والناشط السياسي حمودة بربر، وأن المحامين لا يعلمون مكان احتجازه، ما يفيد بممارسة سياسات الإخفاء القسري التي هجرتها تونس عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأفادت وسائل الإعلام التونسية أن وزير الداخلية المكلف من قيس سعيد، وهو رئيس الامن الرئاسي، قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
قبضة الرجل الواحد
جمد الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو، عمل البرلمان، وأقال وزراء بارزين وتولى السلطات التنفيذية والإشراف على النيابة العامة، قائلاً إنه يتعيّن عليه إنقاذ البلاد التي تعاني أسوأ انتشار للفيروس حتى الآن واقتصاداً فاشلاً.
ورحب العديد من التونسيين بخطوته، ووصفها البعض بأنها انقلاب. وأعربت وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان عن انزعاجها من إغلاق مكتب الجزيرة الإخباري في تونس العاصمة.
في الأيام الأخيرة، تعهد سعيّد ملاحقة المشرِّعين ورجال فاسدين وعزز الرقابة العسكرية على حملة مواجهة فيروس كورونا وأغلق مقر الحكومة والبرلمان بقوات من الجيش وفرض حظراً مشدداً على التجوال.
وقرر سعيّد في 30 تموز/يوليو، منع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، كما جاء في الأمر الرئاسي أنه على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها الإغلاق التام ابتداءً من الساعة السابعة مساء.
—————————-
=========================
تحديث 04 آب 2021
—————————-
تونس 25 يوليو: عن الديمقراطية والحنين إلى سلطة استثنائية/ برهان غليون
(1)
بصرف النظر عن تعريف ما حصل في تونس في 25 يوليو/ تموز الماضي، تشكّل العودة إلى الحال الاستثنائية، سواء أطلقنا عليها اسم انقلاب أو حركة تصحيحية أو مواجهة للفساد، نكسة حقيقية للمسار الديمقراطي الذي أطلقته الثورة الشعبية التونسية (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010). ولا تعني النكسة أن قضية الديمقراطية فقدت وهجها وراهنيتها لدى الرأي العام الذي تفاعل قسم منه إيجابياً مع تعطيل المؤسسات الدستورية واستلام رئيس الجمهورية السلطة الكاملة في البلاد. لكنها تشير بالتأكيد إلى فشل الأحزاب والقوى السياسية التي أنتجت النظام الديمقراطي الجديد، وفي مقدمها حركة النهضة، في توطيد أركان هذا النظام وتعزيز شرعيته وضمان تماسكه أمام المشاريع الانقلابية التي تواجه أي ديمقراطية فتية، أجاءت بفذلكة دستورية أم من دونها لا فرق، فجميع هذه الأحزاب السياسية التي شاركت في بناء نظام ما بعد الثورة، وتجسيداً لقيمها وتطلعات جمهورها، تتحمّل المسؤولية في وصول التجربة الديمقراطية التونسية إلى ما وصلت إليه، حتى لو كان لحركة النهضة النصيب الأكبر منها، لأنها كانت الحزب الأكثر نفوذاً وفاعلية في تسيير هذا النظام الجديد، أو بالأحرى في الفشل في تشغيله بما يحقق التطلعات التي كان الجمهور ينتظره منه.
وليس لهذا الفشل علاقة ضرورية بالأيديولوجية الإسلامية التي ترفع لواءها “النهضة”. كما لن يعمل تهميش الحركة أو إخراجها من المنافسة السياسية على تحسين الإدارة أو الارتقاء بأداء الأحزاب الأخرى المنافسة. بل، على الأغلب، إنه سيفاقم من عجز النخبة السياسية التونسية بأكملها عن بناء نظام سياسي أكثر استقراراً، وأقلّ من ذلك قدرة على الاستجابة الفعالة لتطلعات الجمهور الغاضب. ومن الصعب لهذه الأحزاب أن تضمن وحدها العودة إلى أي نظام ديمقراطي، والحيلولة دون المغامرات الشعبوية التي تشجّع عليها اليوم ظروف تونس ومحيطها، مهما كان سببها ومبرّراتها، سواء أجاءت من داخل النظام أو من خارجه.
وبالمثل، لا أعتقد أن سبب النكوص الشعبوي هو النظام البرلماني لما أتاحه من فرص زادت من تفتّت القوى المكلفة باتخاذ القرار، ومن إشعال روح التناحر والمناكفة لدى نخبةٍ سياسية منقسمة وضعيفة الثقة ببعضها بعضاً، وخاضعة لضغوط البيئة الإقليمية الشديدة التوتر والانقسام. ربما كان من شأن نظام رئاسي أن يتغلب بشكل أفضل على تشتت الأصوات واستسهال المماحكات والنزاعات داخل المجلس النيابي، وأن يسهّل توحيد الكلمة وتنفيذ القرار، وأن يكون بالتالي أكثر فاعلية في مرحلة انتقالية صعبة، وظروف اقتصادية سيئة فاقمت من آثارها الأزمة الصحية العالمية، وضعف الخيارات الداخلية والخارجية. لكن خيار النظام البرلماني لم يكن، في اعتقادي، إلا تعبيراً عن ضعف الثقة بين الأطراف، وتطميناً للقوى والأحزاب الضعيفة على دورها ومشاركتها. على جميع الأحوال، ليس هذا هو السبب في وصول النظام الديمقراطي إلى المأزق الذي “برّر” الانقلاب الذي لا نعرف بعد أيضاً أبعاده ولا مآله، ولا أعتقد أنه يمكن أن يشكّل نهاية المسار الديمقراطي.
للأسف، لا يرى الكثيرون من هذا الحدث الخطير سوى الصراع المديد والعقيم معاً بين إسلاميين وعلمانيين، أي صراعاً على تقاسم النفوذ والسلطة، ومن ورائها الثروة التي تتناقص باستمرار، بمقدار ما تتراجع قدرة النخب الاجتماعية على التفاهم حول برنامج عمل وطني واحد لتعبئة الرأي العام والموارد المتاحة المادية والمعنوية لإنقاذ البلاد وتجنيب الشعب مصير بعض البلدان العربية التي تغرق اليوم في البؤس والفقر والحروب الأهلية.
يمكن للمعادين أو الخائفين من الإسلامويين أن يبتهجوا لرؤية منافسيهم السياسيين يخسرون رهانهم، وربما يخرجون من السباق. ويمكن لأنصار الإسلاموية في تونس والعالم العربي أن يعترضوا على لا شرعية الانقلاب. لكن المسألة ليست هنا، فلا أحد من جمهور الشعب الذي شارك في الثورة أو خرج تأييداً للانقلاب يهمّه من هو الرابح والخاسر من هذا الصراع، فهذه الرهانات السياسوية الضيقة الأفق لا تكاد تعني شيئاً اليوم عند الرأي العام، ولن يكون لها قيمة ولا أثر، أي لن يقدّم ولن يؤخر شيئاً، أمام عجز جميع الأطراف، إسلاميين وعلمانيين، أي الطبقة السياسية جملة، عن تحقيق أي برنامج إصلاح جدّي ينقذ البلاد من تدهور الأوضاع المعيشية، ومعه تفاقم التناقضات والتوترات والإحباطات والمشاحنات. وهنا يتكرّر الشعار ذاته الذي نسمعه في كل مكان “كلن يعني كلن”. المهم بالنسبة للجمهور الملوّع والمهدّد في أمنه الغذائي وصحته وتربية أبنائه هو مشروع هذا الإصلاح الذي يتوقف عليه مصيره وشروط حياته ومستقبله، وليس أي شيء آخر. نحن هنا أمام الدرجة صفر من السياسة وعلى حدود التمرّد والانتفاض.
(2)
عندما حرّرت كتاب “بيان من أجل الديمقراطية” (1977)، وأعتقد أنه كان أول محاولة لاستعادة الفكرة بعد هجرانها الطويل من قبل المثقفين والنخب السياسية العربية الفاعلة لصالح الأفكار القومية واليسارية الراديكالية والماركسية، لم تكن الحريات الفردية هي التي تحتلّ مقدمة المطالَب والخطاب الشعبي. كان وراء استعادة الفكرة الديمقراطية الاعتقاد أنه لا بد من إيجاد إطار يتيح التفاهم حول تداول السلطة والمشاركة فيها، والتخلّي عن فكرة الإقصاء التي سادت الحقبة السابقة من التاريخ السياسي للنظم والأحزاب العربية، وذلك من أجل تسهيل الخروج من مناخ الحرب الأهلية والانقسامات العميقة داخل النخبة بسبب الانتماءات الأيديولوجية، الإسلامية وغير الإسلامية، واليسارية واليمينية، والقومية والقُطرية، والمساعدة على إنتاج إرادة وطنية واحدة تسمح للنخب الوطنية بالتعاون من أجل توحيد الجهد وتكثيف العمل لإخراج البلاد من مأزق التخلف والفقر والبؤس الذي يدمّر معنويات أبنائها، ولفتح آفاق جديدة للجمهور الشعبي الواسع لمقاومة اليأس واحتمال تنامي الرهان على العنف وحركات التمرّد والعدمية السياسية.
وهذا يعني أننا كنا ننظر إلى الديمقراطية من زاوية استراتيجية، هدفها تثبيت الأرض المتزعزة، للتمكّن من تشييد صرح آخر عليها، هو مشروع التغيير. وهذا منهج آخر غير الذي يستخدمه خصومها: الإسلام هو الحل أو العلمانية هي الحل أو الحداثة هي الحل. وأنه لا يوجد حل في أية أيديولوجية أو نظام أو عقيدة أو أخلاق عمومية، وإنما هو في يد القوى الحية الفاعلة على الأرض. وقيمة الديمقراطية تنبع، في هذا المنظور، من قدرتها العملية على تحقيق ثلاثة أمور أساسية لإخراج قوى التغيير من دورانها حول نفسها، وتبديد جهودها في نزاعاتها ولفتح طريق الأمل المسدود:
الأول، توحيد إرادة النخب السياسية وبالتالي الاجتماعية، بالاعتماد على قاعدة شرعية واضحة لتداول السلطة ومشاركة كل الأطراف فيها. والثاني، تقريب هذه النخب التي انفصلت عن الشعب، ولم تعد تفكر إلا بمصالحها ومواقعها ومكاسبها، من جمهور الشعب، وهذا ما يفترضه كسب الشرعية الديمقراطية بالمقارنة مع “الشرعية” الانقلابية التي تؤخذ بالسلاح. والثالث، التغيير الذي أصبح حلماً مستحيلاً مع تسلط أنظمة قمعية وانقلابية، لا هم لها سوى تخليد نفسها ولا يهمها لا من قريب ولا من بعيد تدهور الأوضاع الاجتماعية وحالة التأخر الاقتصادي والثقافي والعلمي والحضاري عموماً. وما يمكن أن يحمله هذا التغيير من إطلاق للطاقات والمواهب وأشكال التضامن والتعاون لبناء اقتصاد قوي قادر على إيجاد فرص العمل وتحسين مستوى الأجور والمعيشة للجميع، وإنشاء مجتمع حديث ونشيط، عضو فاعل ومحترم في المنظومة العالمية للدول والأمم.
بمعنى آخر، لم يكن هدفنا من الديمقراطية أن نقدم لنخبنا السياسية هدية جديدة اسمها لعبة الحرية، أو أن نوفر لهم مجالاً أوسع لممارسة مزيد من التنازع والتناحر والتنافس على المناصب أو على تأييد الجمهور وعلى أصواته الانتخابية، فنحن لسنا في مبارزة سياسية، وليس هذا هو هدف الديمقراطية ولا مبرّر وجودها. وحصوله واستمراره يضع الديمقراطية بالفعل في موقع أسوأ بكثير من موقع الديكتاتورية، لأنه يشيع الانطباع لدى الجمهور الشعبي الذي يعاني بأنها مضيعة للمال والجهد والوقت. ولا يمكن لمثل هذه المسرحية التي تخلق من الآمال بمقدار ما تحبط منها إلا أن تعيد الحنين لدى عامة الناس الذين يتحمّلون عواقبها الوخيمة إلى نمط القيادة التسلطية التي تقود الدولة والمجتمع بيد من حديد، ولو على حساب كرامة الأفراد وحرياتهم وسعادتهم.
(3)
من هنا، أرى أن مسؤولية الانتكاسة التي حصلت للتجربة الديمقراطية تقع على جميع القوى السياسية التي شاركت فيها، لأنها لم تحسن التصرّف بالسلطات الشرعية التي أوكلها الجمهور إليها، واستخدمتها سلاحاً للتنافس فيما بينها، بدل توظيفها في خدمة مصالحها العامة وكسر حاجز التخلف والتبعية والحاجة إلى التسوّل لتامين لقمة العيش. وهذا ما جعل الديمقراطية الجديدة تعيد تجربة الديمقراطيات التي شهدتها بعض البلدان العربية في الخمسينيات والستينيات، في مصر وسورية والعراق وبلدان أخرى، والتي كرّست سلطة طبقة سياسية أغلقت على نفسها، وحوّلت الديمقراطية إلى لعبة خاصة بها، وانشغلت بنزاعاتها وتنافسها على المناصب والنفوذ، وانفصلت عن الشعب بمقدار ما تجاهلت مصالحه. وأصبحت الديمقراطية في ذلك الوقت شكليةً بالفعل، تغطي فيه الحركة الانتخابية وألاعيبها على إرادة الحفاظ على الوضع القائم ومقاومة أي مشروع تغيير أو إصلاح. وعندما لا يعرف النظام الديمقراطي إلا المراوحة في المكان، وحفظ المواقع المكرّسة، وحماية المصالح الخاصة، يفقد مضمونه، ويعمل لغير الأهداف التي ضحّى الناس من أجلها في سبيل تحقيقها.
ليس هذا هو الوضع في تونس اليوم بالتأكيد. ولكن أردت هنا الإشارة إلى الخطأ الذي يقود إلى فشل أي ديمقراطية في أي مجتمعٍ كان، حتى في الديمقراطيات العريقة، ويضعها أمام مأزق كبير. فإذا لم يكن بمقدور الديمقراطية أن تخفّف من حدّة النزاعات العدائية بين القوى السياسية، بل عملت بالعكس على تعميقها، ولا أن تتيح تكريساً أكبر للوقت والجهد، لخدمة المصالح العامة والاستجابة للمشكلات الكبيرة الطارئة، ولا تعكس، بشكل أوضح، إرادة الشعب في مرآتها، ولا تنجح في تجميع قوى أكبر وأكثر انسجاماً واتساقاً وتعاوناً من ثم أقدر على تحقيق التغيير وتعزيز فرص مكافحة التخلف والاستقالة الأدبية والأنانية الحزبية والشخصية، فلن يبقى أمام الشعب الذي راهن عليها إلا العودة أدراجه ونقل رهانه من جديد إلى الديكتاتورية، سواء جاءت في صورة مخلص أو زعيم أكثر إحساساً بمأساة الناس وتعبيراً عن آمالهم، وغالباً أقدر على التلاعب بعواطفهم وأحلامهم. وربما لن يتردّد في تأييد أفعال الانتقام من نخبةٍ يعتقد أنها خدعته وخانت عهودها.
هذا يعني أنه لا قيمة للحريات السياسية، في هذه المرحلة على الأقل من عمر التجربة، إلا بمقدار ما يبرهن نظامها، أي الديمقراطية، على مقدرته على حل المشكلات الكبرى التي تواجه مجتمعاتها. ولا يمكن أن تكون الديمقراطية اليوم، في عالم الفقر والبؤس والتهميش، هدفاً في ذاتها. ولن تكسب شرعية وجودها عند جمهور الشعب، إلا عندما تثبت قدرتها على أن تكون النظام الأكثر مقدرة على التغيير وإدخال المجتمعات في دورة الحضارة والمدنية التي تعيد اليوم صوغ الهوية الإنسانية على ضوء معاييرها ومكتسباتها. وكل ديمقراطية تخفق في ذلك تخسر شرعية وجودها، وتفتح الباب حتماً أمام الديكتاتورية. وهنا يصبح مستقبل الشعوب معلقاً على المصادفة والحظ في أن يمدّها القدر بزعيم قوي ومخلص وحساس لمأساتها يفتح أمامها طريق التغيير والتقدم، أو بمتسلط مفترس، يسومها سوء العذاب، ويحكمها بالحديد والنار، ليحتفظ لنفسه بما يمكن أن يسطو عليه من مواردها وثرواتها.
وفيما يتعلق بالوضع التونسي الراهن، لا أعتقد أن مصير التجربة الديمقراطية قد حسم، وأن الطريق أصبحت معبدة لعودة الديكتاتورية وحكم الأقلية المفروضة بالقوة، سواء أكانت أقلية عسكرية أو سياسية على طريقة الحزب الواحد أو تكتل من الأحزاب. ولا أعتقد أن من الممكن بسهولة تجاوز إرث ثورة الكرامة والحرية الذي كنس أو كاد كل تراث الاستبداد، وما مثله من احتقار للشعب والفرد والإنسان.
لكن استعادة قوى الديمقراطية المبادرة، وقطع الطريق على تطور المسار الانقلابي، لن يكونا ممكنين بعد الآن من دون مراجعة هذه القوى جميعاً، إسلاميين وعلمانيين، يساريين وليبراليين، تجربتهم فيها، والتفكير في أسباب تعثّرها، سواء ما تعلق منها بأساليب العمل والممارسة واتخاذ القرار، أو بالافتقار لخطة مشتركة لمواجهة الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة، أو معالجة أثر البيئة الإقليمية المضطربة التي أثرت عليها، أو الخلل في التضامن الدولي لنظام عالمي متداعٍ. وعلى شفافية هذه المراجعة وصدقها وإدراك الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك المثقفين الذين ساهموا في هذه التجربة العربية الفريدة، مسؤوليتهم المشتركة في إنهاضها، يتوقف الأمل في استعادة الروح الديمقراطية التي أنضجتها الثورة الشعبية، ومقاومة الحنين إلى الزعامة الفردية الكاريزمية، ليس في تونس فحسب ولكن في عموم البلاد العربية، فعلينا جميعاً أن ندرك، في النهاية، أنّ الديمقراطية ليست نبتةً برّية تظهر أينما وكيفما تشاء الطبيعة، وإنما هي نبتةٌ مدنيةٌ تحتاج إرادة واهتماماً ورعاية وتنازلات متبادلة ومناخاً صحياً، ولا تعيش وتستمر في البقاء إلا بمقدار ما يحرص الفرقاء على وجودها ويضحّون من أجل بقائها.
العربي الجديد
—————————————
تونس: الأحزاب السياسية والديمقراطية في أزمة/ مارينا أوتاواي
رجمة أحمد عيشة
شكلّت انتفاضة عام 2011 بداية للمنافسة التعددية الحزبية في تونس؛ إذ كان في البلاد نظام متعدد الأحزاب بحكم القانون منذ عام 1987، ولكن التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الحكومة، هيمن على كل الانتخابات، وحظر المنافسين المحتملين مثل حركة النهضة الإسلامي. فالأحزاب الصغيرة التي سمِح لها بالعمل لم تضِف سوى واجهة ديمقراطية إلى نظام الحزب الواحد بحكم الأمر الواقع. بعد انتفاضات عام 2011، تأسست أحزاب سياسية جديدة بسرعة، حيث يمكن تسجيل حزب جديد بسهولة، إضافة إلى أن عدم وجود حد أدنى من الأصوات في نظام التمثيل النسبي يشجع على الانتشار اللامحدود للأحزاب. اليوم، هناك عشرات الأحزاب على الورق، ويوجد أكثر من عشرين حزبًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤلفة من 217 عضوًا.
يشكل عدد الأحزاب تهديدًا للديمقراطية التونسية؛ حيث إن معظم الأحزاب صغيرة جدًا، وهامشية، ومجزأة لدرجة أنها أبعد من أن تمثل مصالح ناخبيها تمثيلًا فعالًا. حتى حركة النهضة، التي كانت ذات يوم حزبًا منظمًا تنظيمًا جيدًا، ويتمتع بأيديولوجية واضحة، باتت تواجه اليوم أزمة زعامة، ومعرضّة للتمزق بين حملة رئيسها لإعادة بناء الحركة كـ “حزب ديمقراطي إسلامي” جذوره الإسلامية عميقة. لم يعد التونسيون يعتقدون أن الأحزاب يمكن أن توفر حلولًا لمشكلات البلد، وهم سيلجؤون مرة أخرى إلى الشوارع طلبًا للانتصاف من مظالمهم. إن أزمة الأحزاب تتحول إلى أزمة للديمقراطية.
النظام السياسي
ينبغي فهم دور الأحزاب في إطار النظام الرسمي الذي أسسه الدستور. النظام في تونس برلماني، مع رئيس وزراء يختاره البرلمان، ولكن هناك أيضًا رئيسًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام، مع سلطة كبيرة على السياسة الخارجية والعسكرية. ولقد سعى الرئيسان منذ عام 2014 إلى زيادة قوتهما، على حساب رئيس الوزراء، ولم يحالفهما النجاح حتى الآن إلا في خلق التوترات. ويهدد التنافس بين الرئيس ورئيس الوزراء سلطة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تنتخب رئيس الوزراء. تنتخب الجمعية الوطنية أيضًا المتحدّث الخاص بها، كما الحال في معظم البلدان، وعادة من دون أن تكون هناك مشكلات. ومع ذلك، بعد انتخابات عام 2019، انتخبت الجمعية راشد الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة وأحد الشخصيات السياسية الرئيسة في البلاد، رئيسًا لها، وهو الأمر الذي خلق مركزًا ثالثًا للسلطة، وتسبب ذلك في مزيد من التوترات. أصبحت سياسة تونس سياسة الشخصيات، أكثر من سياسة المؤسسات والأحزاب.
لعبت الأحزاب السياسية دورًا مهمًا في بداية المرحلة الانتقالية؛ فكانت أساسية لانتخابات الجمعية التأسيسية، من أجل تشكيل المجموعة الثلاثية، وهي تحالف الأحزاب الثلاثة التي حكمت البلاد حتى عام 2013. سيطرت النهضة، التي فازت بأكثرية الأصوات في عام 2011، على منصب رئيس الوزراء، في حين تولى حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الرئاسة، ورشح التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رئيس الجمعية التأسيسية. ولكن الأحزاب فقدت، في عام 2013، تأثيرها على العملية السياسية، وتخلت عن المبادرة لمنظمات المجتمع المدني، ولم تقم بإعادة تأسيسها قطّ.
كانت الجمعية التأسيسية بطيئة للغاية في كتابة الدستور الجديد، وأدى ذلك إلى نفاد الصبر في البلد. ومما يزيد الطين بلة أن اغتيال شكري بلعيد، السياسي اليساري البارز، في شباط/ فبراير 2013، قوّض الثقة في النهضة، التي اتهِمت -على نحو خاطئ- بأنها وراء عملية الاغتيال. فقد زعم حمادي جبالي، رئيس الوزراء حينذاك، أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة لا بد من أن تتنحى جانبًا لصالح حكومة أوسع نطاقًا، ولكن رفض اقتراحه، واستقال من الحزب. وخلفَه بعد بضعة أشهر زعيم آخر من النهضة، هو علي لعريده. وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي تسيطر فيها حركة النهضة على الحكومة.
صعود وتراجع السياسات الحزبية
في أسوأ مرحلة من الثقة في الجمعية التأسيسية المنتخبة والأحزاب، انتقلت مبادرة حل المأزق إلى منظمات المجتمع المدني في المجموعة الرباعية للحوار الوطني. وشملت المجموعة الرباعية الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أصحاب العمل، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ورابطة المحامين. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، بعضويته الكبيرة وفروعه في جميع أنحاء البلد، أهمّ منظمة. وكانت المجموعة الرباعية منظمة غير تمثيلية ذاتية التعيين، ولكن الأحزاب السياسية كانت في حالة انحدار، ولذلك فقد قبلت. وطالبت المجموعة الرباعية حركة النهضة بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء الذي يحقّ لها أن تشغله نتيجة الانتخابات، وأن تقبل، بدلًا من ذلك، تشكيل حكومة “تكنوقراطية” بقيادة مهدي جمعة، وهو شخصية مستقلة. وكان هذا هو الحل الذي اقترحه حمادي جبالي، في وقت سابق، من دون أن يكتَب له أي نجاح، ولكن هذه المرة وافقت النهضة. وبضغط من اللجنة الرباعية والجمهور، وافقت جميع الأحزاب في الجمعية التأسيسية أيضًا على التعجيل بكتابة الدستور، والتوصل إلى الحلول التوفيقية اللازمة والموافقة على الوثيقة في كانون الثاني/ يناير 2014. جنبت هذه العملية انهيار المرحلة الانتقالية، ولكن المجموعة الرباعية أهملت الأحزاب.
عادت الأحزاب لفترة وجيزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2014، مع سيطرة النهضة ونداء تونس. كانت حركة النهضة إلى حد بعيد هي الحزب السياسي الأفضل تنظيمًا في تونس، لكنها جاءت في المرتبة الثانية بعد حزب نداء تونس، وهو منظمة غير مكتملة واسعة، أسسها الباجي قايد السبسي، وهو من قدامى المحاربين في نظام بورقيبة. لم يكن لدى نداء تونس أيديولوجية ولا هيكل حزبي حقيقي. تكاملت سمعة السبسي وفطنته السياسية وانعدام الثقة بالنهضة من جانب العديد من التونسيين العلمانيين.
فاز السبسي بالرئاسة في الانتخابات التمهيدية، ضد منصف المرزوقي، الرئيس في عهد الترويكا، شارك عشرون مرشحًا في الجولة الأولى من التصويت الرئاسي، ولكن النهضة قررت عدم دخول هذا السباق. كما فاز نداء تونس في الانتخابات البرلمانية، وحصل على ستة وثمانين مقعدًا مقابل تسعة وستين للنهضة. أما المقاعد المتبقية، وعددها (62) مقعدًا، فقد توزعت بين الأحزاب ذات التوجهات المختلفة على نطاق واسع، ولم يتمكن نداء تونس من تشكيل تحالف واسع بما فيه الكفاية لتشكيل حكومة. وهكذا اضطر السبسي، بعد حملته الانتخابية المناهضة للنهضة، إلى التوجه إلى عدوه، راشد الغنوشي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
كان الاتفاق ضربة أخرى للأحزاب السياسية. لم يتم التوصل إلى تسوية بين المنظمات، ولكن بين السبسي والغنوشي، وهما الزعيمان اللذان غالبًا ما وصفهما التونسيون، من دون لطف، بالرجلين العجوزين. بالنسبة إلى حركة النهضة، كانت التسوية تسوية أخرى في سلسلة من التنازلات التي أجبر الغنوشي فيها الحزب على قبولها. في عام 2013، كان الغنوشي قد حثّ الحزب على قبول استقالة رئيس الوزراء علي لعريده، واستبداله بمهدي جمعة. واستخدم القوة لإجبار المنظمة على سنّ دستور لا يذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. وأوضح، مرارًا وتكرارًا، وذكر ذلك في محادثة مع الكاتبة، أن الشريعة ليست مدونة قانون، إنما هي ثلاثة عشر قرنًا من التفسيرات من قبل مدارس الفقه الإسلامي المختلفة، وجادل بأن الإشارة البسيطة إلى الشريعة في الدستور لا تعني شيئًا. كان الأمر على حقٍّ من الناحية الفنية، لكنه كان مع ذلك تنازلًا مؤلمًا يقدّمه حزب إسلامي، حيث أحدث كثيرًا من التذمر في صفوفه. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدساتير العربية، ومن ضمنها تلك التي كتِبت للعراق تحت الاحتلال الأميركي، تحتوي على إشارات إلى الشريعة. وعلى ذلك القدر من الجدل، كانت إعادة تعريف الغنوشي لحركة النهضة كحزب إسلامي ديمقراطي، لا كحزب إسلامي. وبالنسبة إلى نداء تونس، كان التحالف مع النهضة رفضًا لسبب وجوده.
نهاية نداء تونس
كانت نتيجة تشكيل حكومة وحدة وطنية فورية، بالنسبة إلى نداء تونس، حيث بدأ الانقسام داخله. تخلى عدد كبير من المسؤولين والمندوبين المنتخبين عن حزبهم، لدرجة أن نداء تونس خسر أكثريته في الجمعية التأسيسية، حيث انخفضت مقاعده إلى ثمانية وخمسين مقعدًا، بينما حافظت حركة النهضة على التسعة والستين مقعدًا. بالإضافة إلى التحالف مع النهضة، كانت نقطة الانشقاق الرئيسة في صفوف نداء تونس هي مستقبل التنظيم. اضطر السبسي إلى التخلي عن دوره كرئيس للحزب عند انتخابه رئيسًا، وبدا أنه من غير المرجح أن يستأنف نشاطه في هذا الحزب، لأنه كان عجوزًا وضعيفًا، على الرغم من أن فطنته العقلية والسياسية كانت سليمة (توفي في النهاية في تموز/ يوليو 2019، قبل انتهاء فترة رئاسته). حاول السبسي تسمية ابنه حافظ، ليكون المدير التنفيذي للحزب، ومن المفترض أن يكون خليفته، في خطوة مثيرة للجدل أدت إلى تسريع الانسحاب الجماعي من الحزب. بحلول موعد انتخابات 2019، خلص كثيرٌ من المحللين إلى أن نداء تونس لم يعد عاملًا في السياسة التونسية، وقد نجح بالفعل في الفوز بثلاثة مقاعد فقط.
رؤساء وزراء من دون أحزاب
مع تفكك حزب نداء تونس، ورفض النهضة التقدم والمطالبة برئاسة الوزراء، حيث قال الغنوشي إن مثل هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل للغاية؛ استمرت أهمية الأحزاب السياسية في التدهور. ذهبت رئاسة الوزراء في ظل حكومة الوحدة الوطنية إلى المستقل حبيب الصيد، حيث لم يستطع نداء تونس ولا النهضة المطالبة بالمنصب. ظل الصيد مترنحًا لأقل من عامين، بسبب الركود الاقتصادي، ومعدلات البطالة المرتفعة، والحكومة المنقسمة بين ممثلين عن نداء تونس، والنهضة، وآفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وهي أحزاب لم تتشارك حتى في الحد الأدنى من البرنامج المشترك. نتيجة لذلك، لم يحقق مجلس الوزراء الكثير، وفي تموز/ يوليو 2016 خسر التصويت بحجب الثقة.
ابتلي رئيس الوزراء القادم يوسف شاهد بالمشكلة نفسها، وكان عضوًا في نداء تونس، حيث كان الحزب منقسمًا جدًا لدرجة لم يعد من الممكن أن يزوده بقاعدة قوية من الدعم. نجح في دفع بعض الإصلاحات الاقتصادية التي كانت هناك حاجة ماسة إليها، ولكن هذا جعله أكثر إثارة للجدل، وهو ما أدى في عام 2018 إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع، بدعمٍ من اليسار ضد تدابيره “الجائرة”. وبينما كان شاهد يحاول الحفاظ على تماسك حكومته والحفاظ على دعم الجمعية، وينمّي طموحه الشخصي في الترشح لمنصب الرئيس، تخلى عن نداء تونس المحتضر، وفي كانون الثاني/ يناير 2019، أطلق حزبًا جديدًا، تحيا تونس، ليكون أداته الخاصة. على الرغم من كل الجدل وعدم التقدم الاقتصادي، نجح شاهد في الحفاظ على موقفه والتنحي فقط، كما هو مطلوب بموجب القانون، بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2019، نجح بالاستمرار ثلاثة أعوام ونصف، وهي أطول مدة لرئيس وزراء منذ عام 2011.
أدت انتخابات 2019 إلى صعود الرئيس قيس سعيّد، الذي رفض الانضمام إلى أي حزب سياسي أو تشكيل حزب خاص به. كرجل قانون بارز، قام بحملة بناء على سمعته المحلاة بالنزاهة، وفاز بدعم كبير من الشباب. وشهدت انتخابات الجمعية الوطنية مزيدًا من الخسارة في نفوذ الأحزاب، حيث تم تقاسم المقاعد بين واحد وعشرين حزبًا، لم يكن لمعظمها نفوذ. حصلت حركة النهضة على أكثرية المقاعد، ولكن العدد كان أقل من الانتخابات السابقة، وحاولت المطالبة برئاسة الوزراء، لكن الحكومة التي اقترحها مرشحها فشلت في الفوز أثناء التصويت على الثقة. كلف الرئيس بهذه المهمة رجلًا آخر، لم يكن له حزب عمليًا. كان إلياس الفخفاخ عضوًا في حزب التكتل، لكن هذا الحزب، الذي كان يومًا ما عنصرًا مهمًا في الترويكا التي حكمت في ظل الجمعية التأسيسية، تضاءل وطواه النسيان، وفشل في الحصول حتى على مقعد واحد في عام 2019. تمكن الفخفاخ من تشكيل حكومة في 27 شباط/ فبراير 2020، لكنها كانت ضعيفة ومنقسمة بشدة منذ البداية، وغير قادرة على معالجة المشكلات المهمة. بعد ستة أشهر باهتة، كانت القشة التي قصمت ظهر الحكومة هي مزاعم الفساد ضد الفخفاخ (الشركات التي كان له أسهمٌ فيها فازت على ما يبدو بعقود حكومية بوسائل مخادعة). في 26 تموز/ يوليو، سحبت حركة النهضة دعمه، وقدم الفخفاخ استقالته. اختار الرئيس، الذي كان يحاول توسيع سلطته، هشام المشيشي، المقرب منه، الذي لا ينتمي إلى أي حزب، لتشكيل الحكومة. نجح المشيشي، لكن بحلول كانون الثاني/ يناير 2021، اضطر إلى تعديل وزاري للاحتفاظ بثقة الجمعية الوطنية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بسبب تفشي وباء (كوفيد -19) وتصاعد التوترات بينه وبين الرئيس.
تراجع حركة النهضة
كانت حركة النهضة، التي ظلت الحزب السياسي الحقيقي الوحيد في تونس، بمنظمة ومنصة، في حالة أزمة أيضًا بحلول منتصف عام 2020. لطالما كانت هناك توترات بين الجناح الأكثر اعتدالًا والبراغماتية المتمركز حول راشد الغنوشي، والمتشددين الذين شاهدوا تنازلات الغنوشي بفزع وارتباك. نجح الغنوشي في جذب معظمهم مدة طويلة بشكل مدهش. لكن بحلول عام 2020، أصبحت المهمة مستحيلة، في وقت كانت فيه الحركة تواجه أيضًا تحديات متزايدة من خارج صفوفها.
وقد سبق أن خرجت حركة النهضة من انتخابات عام 2019 ضعيفة، على الرغم من أنها احتفظت بأكثرية المقاعد. ولم يتمكن مرشحها لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة. وقد نجحت الحركة في السيطرة على الناطق باسم الجمعية الوطنية، ولكن راشد الغنوشي، الذي أصرّ على تولي هذا الدور شخصيًا، أثار جدلًا شديدًا. وكثيرًا ما كان على خلاف مع الرئيس، وغير قادر أو غير راغب في الفصل، بين دوره كمتحدث في الجمعية العامة، ودوره كزعيم للنهضة. على سبيل المثال، في كانون الثاني/ يناير 2020 سافر إلى تركيا، والتقى الرئيسَ رجب طيب أردوغان، على الرغم من أن السياسة الخارجية كانت من اختصاص الرئيس، لا من اختصاص البرلمان، ومن المؤكد أنه لم يكن من اختصاص رئيسه الذي يعمل بمفرده. وعلاوة على ذلك، غرقت الجمعية الوطنية تحت قيادة الغنوشي في الفوضى، مع تنامي الشقاق بين الأحزاب، ولا سيّما بين حركة النهضة والحزب الدستوري الحر. ومع وجود 17 مقعدًا فقط، كان الحزب الدستوري الحر ثالث أكبر الأحزاب في الجمعية المنقسمة، وكانت تقوده عبير موسى، وهي امرأة محافظة علمانية إلى حد بعيد، التي كانت تبرز بوصفها المتحدي الأعلى صوتًا لحركة النهضة.
في 30 تموز/ يوليو، مع ترنح البلاد بالفعل بعد استقالة رئيس الوزراء، قدّمت أحزابٌ في الجمعية الوطنية اقتراحًا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، واتهمته باتخاذ قرارات بنفسه من دون استشارة المجلس وإصدار تصريحات خاصة حول العلاقات الخارجية التونسية. حصل الاقتراح على 97 صوتًا فقط، بينما كانت الأصوات المطلوبة 109 أصوات، وحافظ الغنوشي على منصبه، لكن سلطته قُوِّضت في المجلس، والأهم من ذلك في حركة النهضة، حيث اعتقد كثيرون أن الوقت قد حان لتغيير القيادة.
لم تعد المعارضة مقتصرة على الجناح الراديكالي للحركة، حيث شكلت مجموعة كبيرة من مسؤولي النهضة والشخصيات المعروفة فيما يسمى بـ “مجموعة المئة”. واستنادًا إلى المادة 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة، التي تمنع رئيس الحزب من البقاء في السلطة لأكثر من دورتين، طالبت المجموعات الغنوشي بالتنحي عن هذا المنصب في المؤتمر الحزبي المقبل، والمتوقع أن ينعقد قبل نهاية 2020. قاوم الغنوشي في البداية، ولكن مع استقالة عدد كبير من أعضاء النهضة البارزين، تعهّد الغنوشي أخيرًا في تشرين الثاني/ نوفمبر بالتنحي في مؤتمر الحركة. لم ينعقد المؤتمر، ولكن الغنوشي جدّد، في كانون الثاني/ يناير 2021، تعهده بعدم الترشح مرة أخرى، وقد تضاءل تأثير التعهد إلى حد كبير من خلال الإعلان عن تأجيل مؤتمر الحركة لمدة عامين.
نهاية الديمقراطية؟
في 20 آذار/ مارس 2021، تجمع المتظاهرون مرة أخرى في شارع بورقيبة، وسط تونس العاصمة، حيث تجمعت الحشود في عام 2011 لإظهار عدم رضاهم عن الوضع الراهن، وقبل كل شيء، للتعبير عن خيبة أملهم من العملية السياسية. كانوا يطالبون بحل الجمعية الوطنية -رفضًا للمؤسسات الديمقراطية التي أدخلت بعد انتفاضة 2011- والأحزاب السياسية التي حولت السياسة إلى صدام فوضوي للطموحات والشخصيات من دون معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة في تونس. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتمّ حل الجمعية الوطنية. لا توجد آليات في الدستور تسمح بحلّ البرلمان المنتخب، والرئيس ليس مستعدًا، على الأقلّ في الوقت الحالي، لإعادة البلاد إلى أيام السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة. ومع ذلك، فهو تذكير صارخ بفشل العملية الديمقراطية في تونس حتى الآن، التي أوجدت مؤسسات وأحزاب يعتقد عدد متزايد من التونسيين أنها لا تمثل مصالحهم.
ولا شك في أن الطرفين يشكلان جزءًا كبيرًا من الأزمة. فهي لا تفي بمهمة تمثيل مصالح ناخبيها ولا تحظى بالاحترام. فهي في أفضل الأحوال أدوات للنهوض بالمهنة السياسية لزعمائها. أظهرت استطلاعات الرأي العام، التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي في أيلول/ سبتمبر -تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أن 20 في المئة فقط من التونسيين يعتقدون أن الأحزاب السياسية فعالة في التصدي لتحديات البلاد. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد 61 في المئة أن منظمات المجتمع المدني فعالة، وحصلت الحكومة الوطنية المنكوبة على 42 في المئة.
كانت تظاهرات 20 آذار/ مارس هي الأخيرة في عدد متزايد من الحلقات التي رفض فيها التونسيون العملية السياسية الرسمية، وتحولوا نحو النزول إلى الشوارع. يحتج الناس بانتظام في جميع أنحاء البلاد. ومن المستحيل أن نعرف عدد الناس الذين ينزلون إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من البلد، من دون إجراء دراسات مفصلة على أرض الواقع. ولكن حتى التغطية الواسعة التي تقدمها وسائط الإعلام الوطنية والدولية، وهي تقتصر على أهم الأحداث، تشير إلى تدفق مستمر من الاحتجاجات في المناطق الداخلية الفقيرة وفي المدن على طول الساحل، ومن ضمن ذلك تونس العاصمة.
إن الاحتجاج كوسيلة روتينية للمواطنين للتعبير عن مظالمهم والمطالبة بالإنصاف يدلّ على فشل الديمقراطية. لقد كانت تونس أكثر نجاحًا من أي بلد عربي آخر منذ عام 2011 في إنشاء المؤسسات والعمليات الديمقراطية الرسمية. ومع ذلك، يبدو أن هذه المؤسسات فشلت في معالجة مشكلات وشكاوى المواطنين، الذين يتجهون إلى أماكن أخرى لإسماع أصواتهم. إن إخفاق الأحزاب السياسية في توفير القناة بين المواطنين والحكومة هو محور هذا الفشل.
تتمثل الخطوة الأولى العاجلة نحو استعادة بعض الثقة في الديمقراطية في فرض تخفيض كبير في عدد الأحزاب السياسية، من خلال وضع حد للتمثيل، كما الحال في معظم الديمقراطيات البرلمانية. من شأن عتبة خمسة بالمئة من الأصوات المدلى بها أن تلغي جميع الأحزاب السياسية الممثلة الآن في الجمعية الوطنية باستثناء خمسة منها. حتى عتبة 2 في المئة ستقضي على جميع الأحزاب باستثناء ثمانية. هذا يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا لاستبعاد وتدمير الأحزاب الموجودة فقط لتعزيز طموحات مؤسسيها، وفرض تشكيل تحالفات وائتلافات حول برنامج. قد لا يكون ذلك كافيًا، لكنه سيكون خطوة نحو استعادة الثقة في الأحزاب والعملية الديمقراطية. ومع ذلك، قد يستدعي الأمر مزيدًا من الضغط من الشارع، وربما من الرباعية الجديدة للعودة إلى نظام ديمقراطي فاعل.
اسم المقالة الأصلية Tunisia: Political Parties and Democracy in Crisis
الكاتب مارينا أوتاواي، Marina Ottaway
مكان النشر وتاريخه مركز ويلسون، Wilson Center، 2 نيسان/ أبريل 2021
رابط المقالة https://bit.ly/2TGWXTe
عدد الكلمات 2630
ترجمة وحدة الترجمة/ أحمد عيشة
مركز حرمون
——————————
الثورة والثورة المضادة… والأزمة التونسية/ موفق نيربية
تعيد الأزمة التونسية المحتدمة حالياً مفهومي الثورة والثورة المضادة إلى الساحة بعد أن استُهلكا حتى الشفافية على أيدينا، وعلى تفاسير متعارضة، يتغيّر فيها الموضوع مع تغيّر الذات. فهل كانت حركة السيسي والجيش في مصر استمراراً للثورة أم فعلاً مضاداً لها؟! وهل كانت سيطرة الرايات السوداء والبيضاء في سوريا استمرارا لثورتها أيضاً أم نقضاً لها؟! وهل كان ما جرى في تونس» انقلاباً» وفعلاً من أفعال الثورة المضادة أم أنه تصحيح لمسار الثورة الذي تعقّد واستنقع؟! والأهم في كلّ ذلك: هل كان الإسلامويون ثورةً وجزأً من ثورة، أم ثورةً مضادة تتلطّى للثورة وراء الزاوية؟!
ينبغي الإقرار أولاً بأن تونس تختلف بالفعل عن غيرها، قبل ربيع 2011 وفيه وبعده. وهي، رغم كلّ الظواهر المكرّرة في أكثر من مكان عربي خفيفة الظلّ في مشاكلها وقضاياها. «إخوانها « أكثر معاصرةً من غيرهم، وانقلابها الطارئ أقلّ فظاظة من غيره.
دشّن الفرنسيون استخدام المصطلح بعد ثورتهم عام 1789، من خلال أنصار عودة الملكية، الذين استطاعوا أن يحققوا انتصاراً مهماً على ثورات 1848 الأوروبية. في حين لم يقف بسمارك عند توحيد ألمانيا وتنشيط نهضتها الاجتماعية والاقتصادية، بل أخذ عن الاشتراكيين مطلبهم، وأسس لضمان صحي ما زالت آثاره قائمة في دولة الرعاية الراهنة. وبعد عدة انقلابات أو ثورات بعد الحرب الأولى، جاء انقلاب هتلر، ومعه قسم غاضب من الشعب الألماني آنذاك، ليحقّق خراباً ما زال يفعل فعله حتى الآن. وفي روسيا كان اسم «الثورة المضادة» اسم علم لكلّ القوى التي حاربت ثورة أكتوبر عسكرياً، ثمّ استمرت كأداة لقمع من رأى ستالين ضرورة لقمعه.
اعترضت حنة آرندت على إطلاق اسم الثورة جزافاً. فتقول في بعض خربشاتها عام 1963 بمناسبة حراك الحقوق المدنية الكبير في الولايات المتحدة إنها لا تقبل» الثورة الفاشية أو المراحل اللاحقة من الثورة البلشفية على أنها ثورات ليس فقط لأن عنصر الحرية كان مفقوداً فيهما تمامًا، لكن أيضًا لأن فكرة تأسيس شيء جديد ومستقر قد اختفت وراء فكرة أخرى هي الثورة الدائمة… ادّعى لينين أن الهدف هو: كهربة البلاد (القضاء على الفقر والتخلف) بالإضافة إلى السوفيتات (شكل جديد من أشكال الحكومة). لكن الثورة لم تنته ولم تصل إلى نهاية. لقد تم إعلانها ثورة دائمة ولاهثة، هي إما تناقض في المصطلحات أو مجرد فكر شمولي».
في صيف عام 2013، كنت في حديث مع سفير مصر لدى إحدى الدول الأوروبية، وحين جاء ذكر ما جرى في الثلاثين من حزيران/يونيو وبعده قلت كلمة «انقلاب» فابتسم وصحّح لي «نحن نسمّيه ثورة». وإخوان مصر وكثير غيرهم – وبينهم علمانيون- ما زالوا يطلقون على الذي حدث اسم» الثورة المضادة».
في سوريا يُطلق اسم «المناطق المحررة» على تلك التي تسيطر فيها قوى معارضة مسلّحة يغلب عليها الطابع الإسلامي والداعم التركي، بل إن أقواها وأكبرها «جهادي» يقع مباشرة تحت تصنيف الإرهاب في القوائم الدولية. ويتحرّج غيرهم من تلك التسمية الفائضة، من دون أن يبادر إلى تسمية مختلفة. ويرى الإسلاميون- وآخرون- فيما يجري على الأرض استمراراً للثورة، في حين يراه غيرهم ثورة مضادة.
كلّ ذلك ينعكس هذه الأيام على الحدث التونسي في خلفيات ردود الفعل وطريقة الرؤية والنظر.
كغيرهم، بدا التونسيون وقد سئموا سياقات ثورتهم بضجيج إسلامييها وفاسديها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية. فجاءت النتائج متعارضة ومختلطة: فشلت النهضة في تمرير مرشّحها إلى الدور الثاني، ونجحت في تصدّر الكتل البرلمانية. واكتسح قيس سعيّد الصناديق بحمولته الشعبوية وضعف خبرته مع نواياه الطيبة، لكن أيضاَ مع توجّه حركة النهضة إلى دعمه بكلّ قواها بعد فشل ممثلها. نجح سعيّد بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات، ونالت النهضة أقل من عشرين في المئة في انتخابات البرلمان، مما جعل الرئيس فائزاً حتى لو حسمنا من أصواته أصوات النهضة، مما جعله مستغنياً وقادراً على «الاستقلال» بنفسه شيئاً فشيئاً. ذلك ينسجم مع المخيال التونسي- العربي- حول صلاحيات الرئيس «القائد» ويفسّر ميل سعيّد وحلمه بتعديل الدستور لإعادة النظام رئاسياً كما كان.
على هذا الخطّ ذاته جاءت إجراءات الرئيس وبيانه في يوم 25 تموز/ يوليو… والرجل حقوقي وقانوني من الطراز الأول، كما كان نشيطاً في حوارات ومناقشات الدستور الحالي عام 2014 مع أن هنالك تعارضاً واضحاً من أول نظرة متواضعة – غير مختصة – للمادة 80 التي استند إليها الرئيس مع إجراءاته التي أعلنها ونفّذها، على الأقل من حيث تجميده للبرلمان وإغلاق أبوابه مع النصّ على جعل اجتماعه مفتوحاً في المادة المذكورة. ربّما كان الملك عارياً، ونحن لا نرى ذلك! ربّما أيضاً لا نريد أن نرى الأمر، لأنه ليس جوهر المشهد والمسألة والأزمة، بل شكلها الخارجي، الذي حدّدته ثغرات البناء وسياقات إعادة تأسيس النظام والدولة واستقرارهما، وكذلك مسار الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية – الصحية المستحكمة بالناس.
في الثغرات هنالك غياب المحكمة الدستورية وتعطيل اختيار أعضائها عجزاً أو عمداً، ويتسبب هذا حالياً في التخبّط أمام الإجراءات والتوجّهات. وفي السياقات يبدو أن هنالك حالة فساد وصلت إلى حدّ التفسّخ، بانعكاساتها على الحياة السياسية وتشويهاتها لكلّ مجالات الحياة الأخرى، مع تدهور في الإدارة وصل إلى شفا الكارثة مع جائحة كورونا واستفحال أمرها.
بيضة القبان في الأزمة هي حركة النهضة، بوضعها الداخلي على شفا الانقسام والتشرذم، وبعلاقتها مع القوى الأخرى حتى استخدام الضرب المباشر في داخل البرلمان، من دون أيّ استنكار لذلك أو حتى اعتذار فيما بعد. وإذ يشكّل الشيخ الغنوشي – زعيم النهضة ورئيس البرلمان- وزناً كبيراً في الصورة بثباتها أو حركتها، فإن الشكل الشخصي لخلافاته في كل الاتجاهات، وآخرها مع الرئيس، قد أساء إلى تاريخه الطويل، كأكثر زعيم إسلامي اعتدالاً وحداثة في طرائق معالجته لقضايا الاجتماع والسياسة، بالمقارنة خصوصاً مع الإخوانيين في أماكن أخرى.
لم يستطع الغنوشي – وحركة النهضة – الاعتصام بوطنيته التونسية التي طالما تحدّث عنها، وانتقد على أساسها رفاقه من الإخوان المصريين إلى السوريين وغيرهم. حدث ذلك خصوصاً على إثر ما جرى في مصر، التي كانت طموحات الإخوان فيها وإصرارهم على تفرّدهم وامتناعهم عن مراعاة الآخرين سبباً في مأساتهم وفي تدهور الثورة المصرية ومكتسباتها الديموقراطية.
فكما كان الأمر في مصر، حين أدّت مطامع الإخوانيين وعدم مقاومتهم لها إلى تطوّر موقف الجيش ومبادرته ومن ثم تغيير المسار الديمقراطي فإن المسؤول عمّا جرى في تونس هو قوّتها السياسية الأكبر، التي عجزت عن التعامل مع القوى الأخرى على القواعد الحديثة المعروفة، بل أدّت سياساتها إلى تعطيل جوانب ضرورية تتوزع على مروحة شاملة من مكافحة الفساد إلى ترتيب تداول السلطة إلى استكمال العدّة القانونية للنظام.
يختلف الأمر ما بين تونس ومصر، في أن هنالك رئيساً شرعياً بالأساس، يؤكد على أن الإجراءات مؤقتة، وعلى حرية التعبير، ويعترف بالدستور ويستند إليه، وإلى قاعدة شعبية لا ينكرها حتى خصومه، تعيش ظروفاً صعبة تحفزها على تمرير ما لا يمرّ في أوضاع أخرى.
يختلف أيضاً في وجود برلمان منتخب لا يستطيع أحد المساس به وبدوره، لحركة النهضة دور أول فيه، وينبغي لها أن تقتنص الفرصة السانحة لإجراء مراجعة نقدية وذاتية معمّقة. بذلك يمكن للأمر أن يختلف في الأيام المقبلة، وينفتح باب الحوار والبحث عن حلول عملية ودستورية في الوقت نفسه، فتونس عزيزة، وأهلها يستحقون الخير.
أمّا ما يخصّ الثورة والثورة المضادة، فربّما نضطر إلى العودة إلى ما نكره، لنستحضر الأرواح ومفاهيم التقدم والرجعية، ونكفّ عنّا شرّ اختلاط المصطلحات.
كاتب سوري
القدس العربي
————————————-
لماذا تونس مهمة؟/ مروان قبلان
في ظروفٍ اعتياديةٍ ما كان لتونس أن تستأثر، ربما، بكل الاهتمام الذي تلقاه اليوم في دوائر الفكر والسياسة، كما في وسائل الإعلام وأوساط الرأي العام، فهي بلد صغير المساحة (أصغر بلد في شمال أفريقيا)، قليل السكان نسبياً (نحو 12 مليون نسمة) فقير الموارد، ضعيف الاقتصاد (لا يتجاوز ناتجها الإجمالي المحلي 44 مليار دولار وترتيبها على العالم 96). ولهذه الأسباب، لا تشكّل مطرحاً للتنافس الإقليمي والدولي، كما هو حال جيرانها. ولكن أهمية تونس لم تكن يوماً بحجمها، ولا بإمكاناتها الاقتصادية، ولا بدرجة التنافس الدولي عليها، بل بدورها الفكري والحضاري الرائد وإرثها السياسي الملفت عبر التاريخ. فلا تُذكر تونس إلا وتُذكر معها الزيتونة والقيروان، اللتان شكلتا لقرون منارة للفكر والثقافة في شمال أفريقيا. وخلال الفترة بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر أعطت تونس للعرب والعالم اثنتين من أهم الشخصيات في تاريخ الفكر والسياسة الدولية: عبد الرحمن بن خلدون، رائد علم الاجتماع الأشهر (1332 – 1406)، والوزير والمفكر الإصلاحي البارز خير الدين التونسي (1820 – 1890). وفي فترة أقرب، اختارها العرب، من دون كل عواصمهم، لتكون مقراً لجامعة الدول العربية بعد تعليق عضوية مصر عام 1978، واختارتها منظمة التحرير الفلسطينية مقرّاً لها بعد خروجها من لبنان عقب الغزو الإسرائيلي عام 1982، ثم إجهاز النظام السوري على المنظمة في طرابلس عام 1983. وفي 2010، كانت تونس مُفجّرة ثورات الربيع العربي، والوحيدة التي نجت من تداعياته الكارثية، فسلكت طريق الانتقال الديمقراطي. وهذا السبب الأخير، تحديداً، هو ما يجعلها بؤرة اهتمام عربي وعالمي اليوم. إنها النموذج الذي يضع المنطقة على مفترق طرق: نحو الحرية والديموقراطية أو نحو الاستبداد والعبودية.
قبل تونس، لم يكن للعرب في تاريخهم المعاصر ثورة شعبية ناجحة (بدون جيش ودبابات) أسقطت الاستبداد يتمثلونها ويفاخرون بها. بعد تونس، فقدت ثورة إيران قدرتها على الإلهام، وقد صار للعرب ثورةٌ نجحت، بعكس إيران، في إنشاء ديمقراطية. لكن الأهم من ذلك كله أن تونس حطّمت، بتحولها إلى الديمقراطية، أسطورة “استثنائية” الحالة العربية والمزاعم التي سادت الأكاديميا الغربية حول “التناقض الجوهري” بين الإسلام والثقافة العربية والديمقراطية.
الحديث عن أن المنطقة العربية تتميّز بخصائص ثقافية ودينية وبنية فكرية ومجتمعية تجعلها عالقة في الماضي، غير قادرةٍ على المضي إلى الأمام والتصالح مع الحداثة، حديثٌ قديم بدأ مع الفيلسوف الفرنسي، إرنست رينان، في القرن التاسع عشر، واستمر مع برنارد لويس وكثيرين غيره في القرن العشرين. لكن الاستثنائية العربية المزعومة بشأن الديمقراطية لم تبدأ إلا مع موجة التحول الديمقراطي الثالثة في العالم (أشار إليها صمويل هنتغتون في كتاب حمل العنوان نفسه)، وشملت دول جنوب أوروبا (اليونان وإسبانيا والبرتغال) في السبعينيات، ودول أميركا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل) في الثمانينيات. ومع اكتساح الديمقراطية كوريا الجنوبية وتايوان في أواخر الثمانينيات، بدأت هذه الاستثنائية تأخذ منحىً أكثر حدّة، خصوصاً وأن هذه البلدان كانت تمرّ بظروف مشابهة لظروف العالم العربي – الإسلامي (حروب، تخلف، فقر، ديكتاتورية.. إلخ). ثم راحت هذه الاستثنائية تأخذ أبعاداً ثقافية ودينية، مع انهيار الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية وبلوغ الديمقراطية مجتمعات أفريقية (جنوب أفريقيا)، ما جعل الحالة العربية – الإسلامية شبه فريدة.
قبل ذلك، كان العوز الديمقراطي في المنطقة العربية والعالم الإسلامي عموماً جزءاً من حالة عامّة يعيشها العالم الثالث في ظل نظام الثنائية القطبية، وسيطرة الواقعية على السياسة الأميركية. ولكن ظهور تجارب ديمقراطية، وإنْ تعثرت أحياناً، في دول إسلامية مثل باكستان وبنغلادش وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، أثبت أن الإسلام والديمقراطية يمكن أن يتعايشا، ما جعل العرب يبدون وكأنهم المكون الثقافي الوحيد المتبقّي خارج سياق التحول التاريخي الكبير.
نجاح التجربة الديمقراطية التونسية أسقط كل أساطير “الاستثناء” العربية، إذ بيّنت أن العرب، كغيرهم من الأقوام، يقدّرون عالياً قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ويسعون إلى نظم سياسية تمثيلية أساسها القانون. من المهم أن يدرك الرئيس، قيس سعيّد، حجم الرهان هنا، فلا يعود بنا إلى مربع الاستثنائية الثقافية العربية التي ينتظر القائلون بها فشل التجربة التونسية حتى يدمغونا بها مرّة واحدة وإلى الأبد. هذه ليست إذاً مسألة حزبية محلية، أو خلاف سياسي، أو طموح شخصي، بل هي مسألة عربية تاريخية كبرى، وينبغي التفكير بها على هذا الأساس.
العربي الجديد
————————–
تونس نحو ديكتاتورية غير معلنة/ علي أنوزلا
دخلت تونس الأسبوع الثاني من “حركة” الرئيس قيس سعيّد، وكل المؤشرات تدل على أن البلاد تنجرف تدريجيا نحو ديكتاتوريةٍ غير معلنة، فقد بات واضحا أن الوعود التي أطلقها الرئيس، ليلة الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي، لن يفي بها على الأقل في الموعد الذي حدّده هو نفسه لتنفيذها، فهو لم يعيّن حتى الآن رئيسا للحكومة، وعوض ذلك بدأ بوضع مستشاريه في مناصب وزارية مؤقتة، وبطريقةٍ غير دستورية. كما أنّ مهلة شهر التي أعلن عن تعطيل عمل البرلمان خلالها أصبحت قابلة للتمديد وإلى أجل غير مسمّى. أما تعهده بحماية الحقوق والحريات، فالرجل يثبت كل يوم أنه يعاني من شرخٍ كبيرٍ بين ما يُنظّر له وما يطبّقه على أرض الواقع. يؤمن بالدستور ويقول إنه يقدّسه، لكنه يعطي لنفسه حق تأويله، حسب فهمه واستيعابه نصوص هذا الدستور، وبما يرضي طموحه ويعزّز صلاحياته، وعلى من يخالفه الرأي العودة إلى مراجعة دروسه في القانون الدستوري، كما سبق أن قال ذات نوبة غضبٍ في إحدى خطبه المونولوغية. أما حرية التعبير فهي مكفولة بالقانون، ما دامت تساند حركته، ولا تقاطع “محاضراته” أمام المراسلين الأجانب في أدب المقارنة بين الدستور التونسي والدساتير الغربية!
حتى الآن، كل ردود الفعل الداخلية والخارجية تساهم في دعم التوجّه الغامض للرجل اللغز، خروج جزء من الشارع التونسي الغاضب بسبب الأزمة الاقتصادية ليلة الإعلان عن “قرارات الرئيس” لتأييده، والإحساس بالانتقام والشماتة من حزب النهضة الذي عبرت عنه بعض النخب المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية، وتراجع “النهضة” عن المواجهة والتعبير عن استعداده لتقديم تنازلات، وبرقيات التأييد والمساندة من أنظمة سلطوية في المنطقة، والحياد البارد الذي عبّرت عنه عواصم الغرب مما يحدث في تونس، كلها عوامل لن تزيد سوى من ترسيخ عقدة الزعامة عند رئيسٍ يفتقد إلى كاريزما الزعيم.
الرجل عكس ما يشاع عنه، تعوزه الفصاحة، ويفتقد إلى بلاغة العبارة وبراعة الكلام. في أحاديثه المرتجلة عنّة تخذله عندما يريد الاسترسال في بسط أفكاره، فتتكسر حبال صوته الجهوري حد التلعثم، وسرعان ما ينعكس ذلك على ملامح وجهٍ متشنجٍ يشبه القناع، يصعب قراءة تعابيره الخالية من أي ابتسام أو انشراح. وهو قبل ذلك رجل مناهض للنظام أو “السيستم”، مثل دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لكن الأول تم ترشيحه من الحزب الجمهوري، والثاني أسّس حزب الجمهورية إلى الأمام بعد انتخابه رئيسا، ليشكل له حزاما سياسيا داخل برلمان بلاده. أما سعيّد فما زال يمقت الحياة السياسية ولا يؤيد عمل البرلمان ويحارب الأحزاب، سيرا على خطى الديكتاتور الليبي معمر القدافي الذي منع تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها داخل “جماهيريته”، ورفع شعار “من تحزّب خان”. سعيّد هو نسخة مشوّهة من كل هذه النماذج السيئة الثلاثة، شعبوي يفتقد إلى ثروة ترامب وديماغوجيته وقدرته الكبيرة على التواصل والمراوغة، وتكنوقراطي في زي موظف حكومي نمطي لا يملك خبرة ماكرون ودهاءه في إدارة الاقتصاد ومعرفة خبايا عالم المال والأعمال، وسلطوي تنقصه كاريزما ديكتاتورية القذافي وصلافته وتعجرفه.
منذ انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لم يفعل الرئيس قيس سعيّد أي شيء يفيد البلاد والعباد، كرّس سنتين تقريبا من حكمه في تدبيج الخطب والرسائل الطويلة التي تعطي الدروس النظرية عن صلاحيات الرئيس الدستورية، مع العلم أن الدستور التونسي ينظم، بطريقةٍ عقلانيةٍ إلى حد ما، توزيع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويعطي للبرلمان دور مراقبة السلطة التنفيذية. لكن سعيّد الذي يقول الذين يعرفونه إنه لم يكن سوى أستاذ مساعد في كلية القانون في سوسة وتونس العاصمة، ولم يحصل على درجة الدكتوراه، ظل يمارس دوره في إعطاء الدروس التطبيقية عن الدستور، مثل أي أستاذ قانون مساعد، ولكن هذه المرّة من داخل القصر الرئاسي، وفي الوقت نفسه، يعمل على تمديد صلاحيات الرئيس تدريجيا، استعدادا لبلوغ طموحه بتعديل الدستور الذي من شأنه أن يمنحه مزيدا من الصلاحيات التي تؤسّس لديكتاتورية دستورية، تماما كما فعل ديكتاتور تونس السابق، زين العابدين بن علي، الذي جاء إلى السلطة بانقلابٍ دستوري أبيض ضمّنه بين سطور شهادة طبية مزوّرة لرئيسه المريض أو المحتضر رغما عنه، الحبيب بورقيبة، مسنودا بتأييد شعبي عفوي، كان أقصى طموح من عبّروا عنه هو التغيير من دون معرفة إلى أين سيؤدي بهم ذلك، ومعزّزا بكثير من الوعود باحترام التعدّدية السياسية وصيانة الحريات والحقوق، وانتهى به الأمر إلى تأسيس واحدةٍ من أقبح الدول البوليسية في العصر الحديث، جثمت على صدور التونسيين زهاء ربع قرن من الحكم الفردي المتسلط.
حتى الآن، استفاد سعيّد من التأييد الشعبي لحركته، ومن دعم بعض النخب لها، لكن عدم قدرته على الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي شجّعها، وخذلانه النخبة التي تهلل لقراراته اليوم، قد يؤدّيان به إلى الانجراف نحو منعرجات الاستبداد. وعندها سيجد من يتبعونه أنفسهم أمام خيارين، كلاهما وجه لعملة واحدة: “ديمقراطية سلطوية” أو “سلطوية ديمقراطية”، فالرئيس سعيّد الذي يدّعي أنه جاء محمولا على رياح الثورة، على الرغم من أنه لم يكن معارضا للنظام الذي أسقطته، يحنّ إلى العودة إلى سلطوية الدولة في عهد الرئيس الهارب بن علي. وإذا لم تتدارك القوى الحيّة في تونس الوضع، وتتحرّك لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية، فإن الرئيس سعيّد الذي يختزل الممارسة الديمقراطية في النصوص الجامدة، سينغمس بالبلاد في ديكتاتورية جديدة بعد عشر سنوات من محاولات الانتقال الديمقراطي المتعثر. والمفارقة أن مدافعين كثيرين عن الديمقراطية في أوساط النخبة التونسية، بل حتى في بعض الدول العربية، يعتبرون ما قام به الرئيس التونسي عملا رائعا، فقط لأنه وضع حدّا لما يعتبرونها “هيمنة” حركة النهضة الإسلامية على الحياة السياسية منذ قيام الثورة. وهؤلاء مثل من يراهن على الحصان الأسود في السباق، وقد يُصابون بخيبة أمل كبيرة، لكن الأوان سيكون قد فات عندما تنجرف البلاد نحو نظام ديكتاتوري، لا يُعلن صراحة عن اسمه.
العربي الجديد
—————————-
حلم قيس المستحيل والمعضلة التونسية!/ خالد منصور
انخفض إجمالي الناتج المحلي في تونس نحو 9 في المئة عام 2020 وعلى رغم توقع البنك الدولي أن ينتعش الاقتصاد قليلاً هذا العام فقد شدّد في آخر تقاريره على أن الخلل الهيكلي في الاقتصاد مستمر، وأن البلاد قد تعجز عن مواجهة تحديات خفض عجز الموازنة…
تواجه تونس مزيجاً من تركة اقتصادية ثقيلة وواقع إقليمي ودولي غير موات يجعل محاولات الفكاك من أزمتها السياسية الراهنة بالغة الصعوبة، وهكذا ربما لا تفعل وعود الرئيس الحالي قيس سعيد الضخمة وتطميناته اللغوية المزخرفة، سوى قذف كرة الصراع السياسي الحقيقي خارج الملعب الذي تقوم فيه المؤسسات السياسية الوطنية ويُفترض أن يحكمه الدستور.
ولكن هذه الكرة لن تذهب بعيداً، وعلى الأغلب ستتقاذفها أيادي الدائنين الخارجين والداخلين وتكلفة تسيير الدولة التي تعاني من عجز مالي يتعدى 4
مليارات دولار حتى نهاية العام، وستركلها الاقدام الغاضبة للتونسيين ممن تحطمت أحلامهم البسيطة في العمل والترقي في السنوات القليلة الماضية، بينما ستتلاعب بها بلدان مثل الجزائر والإمارات وفرنسا في محاولة لخدمة أهدافها الاستراتيجية أو الايدولوجية، بينما سيحاول صندوق النقد الدولي التحكم في الكرة كي تعود لملعب يحدد هو إطاره.
ومذ أطاحت هبة شعبية بالنظام المتعفن للديكتاتور زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011، حصلت تونس على حريات سياسية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، ولكن من دون تحقق أحلام وآمال الأغلبية في تأمين حياة وفرص عمل أفضل، إذ لم تغير النخبة الحاكمة للبلاد والتي اتسعت كثيراً في السنوات العشر الماضية، النظام الاقتصادي البتة. وكان فشل هذا النظام الاقتصادي التنموي والذي تدافع عنه مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بين أهم أسباب انهيار نظام بن على الأمني، لأنه كان يعمق الفوارق الهائلة في الثروة والقدرة المادية لمصلحة فئات قليلة العدد ويعتاش على القروض المتزايدة من الدول الأوروبية ولا يهتم بسخط الشعب الذي كان يقمعه بانتظام.
وبعد تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية وازدياد العجز السياسي في العامين الماضيين، قرر الرئيس سعيد تولي الحكم التنفيذي مباشرة وطرد رئيس الوزراء هشام مشيشي، وعلق عمل البرلمان مستغلاً قراءة مخالفة لنصوص وروح الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يسمح للرئيس باتخاذ تدابير استثنائية في حالات الطوارئ ولمدة ثلاثين يوماً فقط. ويبدو أن سعيد، الأستاذ الجامعي الدخيل على السياسة والمنتخب عام 2019، يحلم بإسقاط النظام البرلماني وإعادة تدشين نظام رئاسي يصبح فيه هو ذاته الزعيم والأب القادر على تقويم اعوجاج عالم السياسة المضطرب.
لا تختلف تونس في ظهور هذا الحلم بمجيء المستبد العادل والمخلص من دول عدة من الولايات المتحدة حتى البرازيل والفيليبين حيث يبدو الرجل القوي المسيطر الآتي بانتخابات ديموقراطية هو المخرج من إشكاليات سياسية واقتصادية مستعصية وغضب وقلق شعبي عميق. وعلى الأقل يمنح دونالد ترامب (الرئيس الأميركي السابق) وجايير بولسانارو (الرئيس البرازيلي) ورودريغو دوتيرتي (الرئيس الإسباني) مؤيديهم بعض الامل والحلم في التغيير السهل البسيط، عبر التخلص من السياسيين ورجال الأعمال الفاشلين والفاسدين وتطبيق دعاوى واقتراحات الرئيس الملهم للنجاة من المأزق متعدد الأبعاد المحيط بهذه البلاد والذي ربما يستغرق الخروج منه عشرات السنوات.
أزمة تونس المستحكمة
تواجه تونس أزمة صحية عنيفة بسبب تصاعد أعداد وفيات “كوفيد– 19″، لتتجاوز عشرين ألف شخص معظمهم هذا العام ولم يتلق التطعيم ضد الفايروس سوى نحو مليون شخص أو 8 في المئة من سكان تونس وعددهم 11.8 مليون. وعانت البلد من أعلى معدل إصابات في أفريقيا راهناً، ووصل عدد من أصيبوا بـ”كورونا” إلى أكثر من نصف مليون شخص. وفاقم “كورونا” أزمة اقتصادية حادة تتجلى في النسب المرتفعة للبطالة واحتياج الدولة للغوص أكثر في مستنقع الاستدانة الخارجية.
وليست تونس بالمثال الفريد، فمثلها مثل معظم دول الجنوب ومنذ السبعينات رهينة وضع حديدي يفرضه النظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي: تصدير منتجات زراعية أو مواد خام بأسعار مقبولة للخارج وبيع خدمات متدنية القيمة المضافة مثل السياحة مقابل استيراد المنتجات المصنعة وبخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا. وبين ما يحصل عليه أي بلد من الصادرات وما يضطر لإنفاقه على الواردات والطاقة هناك فجوة كبيرة تسدها الديون التي باتت دول كثيرة تلجأ إليها كحل مستدام لتغطية الفجوة المستمرة بين الصادرات والواردات، وسداد أقساط الديون القديمة وفوائدها أيضاً. وكانت أمام تونس فرصة لم تنتهزها لتصر على إسقاط ديون نظام بن علي بعد سقوطه، وربما لم تفعل هذا خشية إغضاب الدائنين الأوروبيين وهم حلفاء سياسيون بشكل أو آخر للطبقة السياسية التونسية.
وبلا شك تضرر الاقتصاد الضعيف، وبخاصة القطاع السياحي المهم، بسبب هجمات إرهابية دموية وصلت لأقصاها عام 2015، وشملت قتل سياح في منتجعات شاطئية. وعلى رغم نجاح الأجهزة الأمنية اعتباراً من 2016، في صد هجمات الإرهاب وتقليصها بدعم دولي مؤثر، إلا أن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تتعامل بشكل فعال مع أي روافد مهمة للتطرف واليأس المنتشر بين الشباب التونسي. وعلى سبيل المثال، زادت الولايات المتحدة من برامج التدريب والمساعدة الأمنية لتونس عشرة أضعاف لترتفع من 12 مليون دولار عام 2012 إلى 119 مليون دولار في 2017، بينما لا تتجاوز قيمة كل الدعم الأميركي للاقتصاد التونسي ولعمليات التحول الديموقراطي منذ 2011 نحو 350 مليون دولار أو نحو 35 مليون دولار سنوياً.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي في تونس نحو 9 في المئة عام 2020 وعلى رغم توقع البنك الدولي أن ينتعش الاقتصاد قليلاً هذا العام فقد شدّد في آخر تقاريره على أن الخلل الهيكلي في الاقتصاد مستمر، وأن البلاد قد تعجز عن مواجهة تحديات خفض عجز الموازنة وخلق الوظائف وتقليل الفقر في الوقت الذي سيتعين عليها فيه تنفيذ إجراءات تقشفية للحصول على قرض صندوق النقد. ووصلت نسبة البطالة في تونس إلى 17.8 في المئة في الربع الأول من هذا العام وفق الإحصاءات الحكومية ليبلغ عدد العاطلين من العمل أكثر من 740 ألف شخص. وتزايدت الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في العامين الماضيين لمعدلات غير مسبوقة منذ ثورة الياسمين في 2011، وتصاعدت المواجهة الأمنية العنيفة لها وتم اعتقال مئات الأشخاص.
وعلى الصعيد الهيكلي لم تفعل النخب الحاكمة في تونس الكثير منذ سقوط بن علي لتغيير الاقتصاد الذي يعاني من سيطرة عدد قليل من الشركات ورجال الأعمال، أحياناً بشكل احتكاري، على مجالات التصدير والاستيراد، والأنشطة الزراعية، والسياحية والتعدينية. بل وعجزت هذه النخب عن اجراء تغييرات سياسية أعمق من تحويل النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، فلم يقع اصلاح حقيقي لقطاع أجهزة الأمن او القضاء أو الإعلام. وانشغلت النخب الحاكمة في هذه السنوات العشر مع اعميها في الداخل والخارج بالصراع مع الإرهاب وتحديد دور “حزب النهضة” وسياسات الهوية (مثل وضع الشريعة في الدستور مثلاً).
ووصل قصر النظر السياسي إلى حد مزر عندما دعا رئيس مجلس شورى “حركة النهضة” عبد الكريم الهاروني لتفعيل صندوق “الكرامة” ودفع تعويضات مالية كبيرة لضحايا الاستبداد في سنوات حكم بن علي واشترط على الحكومة تفعيل الصندوق قبل 25 تموز/ يوليو، وتطايرت الانتقادات ضد “النهضة” تتهمها بتقديم رشى سياسية لمؤيديها، بل وانتقد زعماء في الحركة توقيت الدعوة فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع أعداد ضحايا “كوفيد- 19”. وأتت دعوة الهاروني لدفع هذه المخصصات، على رغم تزايد الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية والصحية مع استمرار عجز الحكومة والبرلمان عن إقرار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو أربعة مليارات دولار. وتواجه الحركة صراعاً داخلياً حتى من قبل قرارات الرئيس سعيد، حتى إن زعيمها راشد الغنوشي (80 سنة) اضطر لتأجيل اجتماع مجلس الشورى الأخير قبل ساعة من انعقاده وسط نداءات وبخاصة بين شباب الحركة، تدعو إلى تغييرات واسعة في القيادات وتحملها مسؤولية الفشل السياسي.
عنتريات سعيد الشعبوية
حصل الرئيس سعيد على دعم وتصريحات مشجعة من عواصم متعددة مثل الجزائر والقاهرة والرياض وأبو ظبي، وأعلن أنه اتصل ببعض الدول الصديقة من اجل الحصول على دعم مالي، وفي الوقت نفسه أكدت عواصم أخرى منها باريس وواشنطن وقوى داخلية مهمة مثل اتحاد الشغل أن على سعيد ان يعلن سريعاً عن خطة طريق لاستعادة عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقصير فترة سيطرته شبه الكاملة على كل مقاليد السلطة في البلاد. ولكنه حتى الآن وربما بسبب الفشل المزري لمعظم القوى السياسية لم يتلق أي انتقادات حادة داخلية أو مطالبات واضحة خارجية بالتراجع عن قراراته التي يصعب توقع أن تؤدي إلى حل مشكلات تونس المعقدة. وقد تقدم بعض الدول العربية الغنية وبخاصة في الخليج بعض الدعم المادي، ولكنه لن يكون في الاغلب كبيراً، ولن يؤدي في أي حال سوى إلى حلول قصيرة الأمد لمشكلات تونس الاقتصادية.
ولا يساعد في هذا عنتريات سعيد الشعبوية، وعلى سبيل المثال دعوته المصارف إلى خفض نسب الفائدة لتخفيف العبء عن المستدينين او الساعين للاستدانة (بما فيهم الدولة ذاتها) أو مناشدته في فيديو نشره مع رئيس “اتحاد الصناعة والتجارة” التجار بالتحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة.. وتخفيض الأسعار، وأن يتحلوا بشعور وطني أكثر من أي شعور آخر يقوم على الربح او استغلال الظرف للمضاربة أو الاحتكار. وقال الرئيس في اللقاء المصور ذاته بأن حوالى 460 من رجال الأعمال ضالعون في قضايا فساد يصل حجمها إلى 13500 مليار دينار (نحو 4.8 مليار دولار) ودعا للتصالح معهم مقابل أن يقوموا بتمويل مشاريع تنموية تشمل بناء مدارس ومستشفيات وطرق في المناطق الأكثر فقراً في البلاد. وأضاف “هذه أموال الشعب الذي نهبوه وسرقوه. فلوس الشعب تعود للشعب”.
ولا شك في أن هذه التصريحات تدغدغ مشاعر الغاضبين من الممارسات الفاسدة والاحتكارية والحالمين بتغييرات تحسن أوضاع الأغلبية الافقر والاشد يأساً وتضرراً، ولكن لو كانت هناك دروس تمكن الاستفادة منها من التاريخ فهي أن أي حلول حقيقية مستدامة لمشكلات معقدة تتطلب سياسات واضحة وقوى اجتماعية وسياسية منظمة تقف خلفها ومفاوضات وحلول وسط وخطط واضحة بدل خطب شعبوية واختيارات فردية من غير الواضح من يقف خلفها ومن يؤيد سعيد فيها.
وينتهي الباحث الدكتور حمزة المؤدِّب إلى أن نجاح سعيد يتطلب بناء جبهة دعم داخلية تتطلب تدفقات مالية كبيرة “وتنسيقاً مع قوى وطنية ودولية للإبقاء على الزخم الشعبي الذي رافق قراراته أو في أفضل الأحوال للحد من خيبة الأمل التي لا مناص منها لدى قطاعات واسعة. البلد يحتاج الى اصلاحات جذرية، وإلغاء الامتيازات ومواقع الريع وإصلاح جذري للمؤسسات العمومية وعودة الانتاج. هي إصلاحات ستثير غضب قطاعات اجتماعية متنفذة: اتحادات الشغل والأعراف أساساً. هل يمكنه البناء بدون هؤلاء او ضد هؤلاء بدون الدخول في الإكراه. إن نجح فسيكون ذلك حتماً على حسابهم وان فشل فعلى حساب البلد. وهذه هي حقاً معضلة سعيد، والأهم، معضلة تونس ذاتها.
درج
—————————–
هل يتراجع سعيّد عن انقلابه على الديمقراطية؟/ زهير إسماعيل
لم يكن الاختلاف حول طبيعة ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيّد يوم عيد الجمهوريّة أمرًا جديًّا أمام إجماع الأحزاب الديمقراطيّة ومنظّمات المجتمع المدني ومراجع القانون الدستوريّ والجمعيّات والهيئات القضائيّة الدستوريّة والتعديليّة على أنّ الإجراءات المُعلنة انقلابٌ على الدستور والديمقراطيّة ومؤسسات الدولة المنتخبة. ولم تكن كلمته أمام أهمّ المنظّمات الاجتماعيّة إلاّ تبريرًا لمغامرة قد تذهب بالدولة ومؤسساتها وتعصف بالسلم الأهلي.
مقدّمات الانقلاب
كثيرًا ما يُتغافل عن أنّ المنظومة الديمقراطيّة التي استهدفها الرئيس قيس سعيّد بإجراءاته الأخيرة هي التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة. وهو أكثر من يَشهد بأنّه آتٍ من خارج الدوائر المناهضة الاستبداد والدفاع عن الحريّات السياسيّة العامّة والفرديّة. وكان من كرم الثورة أن وزّعت السلطة أفقيّا حتّى اعتلى أعلى المناصب أبناءُ الداخل المهّمش والأعماق المنسيّة. ولا يفسّر هذا السخاء السياسي سوى بحث الدولة الحثيث عن قاعدة حكم متينة تستقرّ عندها في هيئتها الجديدة بعد أن حرّك زلزال الانتفاض الاجتماعي المواطني طبقات الأبنية الاجتماعيّة والتضامنات السائدة وشبكات المصالح المتوارثة، على أمل أن يكون توزّع السلطة الأفقي مقدّمة إلى توزيع أعدل للثروة وجودة العيش.
لم يُخف قيس سعيّد اختلافه مع الديمقراطيّة التمثيليّة ولكنّه قَبل بأن يترشّح إلى منصب رئاسة الجمهوريّة ضمن منظومتها التي بنتها الثورة، وأقسم أمام مجلس نواب الشعب على صيانة دستورها واحترامه. ونُظر إلى هذا الاختلاف على أنّه ممّا تستوعبه الديمقراطيّة باعتبارها اختيارًا شعبيًّا عامًّا وحرًّا. فمن كرم الديمقراطيّة وشجاعتها إتاحتُها الفرصة لمناهضيها مع اشتراطها بأن يكون تجاوزها بوسائل ديمقراطيّة. وعندما عاد قيس سعيّد، بعد أن أصبح رئيسًا للجمهوريّة، إلى التذكير بأطروحته الشكلانيّة في الانتظام السياسي الأفقي، لم يكن من اعتراض من النخبة الديمقراطيّة على ما يعرضه سوى التزامه بما تمّ التعاقد عليه في دستور الثورة واحترام ما انبنى من مؤسسات ديمقراطيّة على ضوئه.
لم يمرّ وقت طويل حتّى بدأ توتّر رئيس الجمهوريّة المحسوب على الصف الثوري مع مؤسسات النظام السياسي سليل دستور الثورة. وقابله توتّر آخر أشدّ في مجلس النوّاب في أولى جلساته تطوّر إلى بلطجة متواصلة من قبل نوّاب الدستوري ممثّل التجمّع المنحلّ عطّلت أشغال المجلس ورذّلت دوره. وبدا واضحًا أنّ نتائج انتخابات 2019 في حاجة إلى قراءة جديدة بعيدًا عن الانطباعات الأولى التي اعتبرتها جولة لفائدة القوى المنتصرة للثورة، بعد أن كانت انتخابات 2014 جولة لصالح القديم. وأمكن ملاحظة انحدار في المشهد السياسي العام من جهة انحسار شروط بناء الديمقراطيّة وتواصل مسارها.
فبعد أن كان الإجماع على مفهوم الدولة، ولقاء بين القديم والجديد وسط العمليّة السياسيّة، ووجود مؤسسة أمنيّة وعسكريّة خارج رهانات السياسة ومغانمها شروط تواصل الانتقال إلى الديمقراطيّة أفصحت انتخابات 2019 عن مشهد جديد. ويتلخّص هذا المشهد في صعود الأطراف (الكرامة/عبير) وضعف الوسط (النهضة) واضمحلال أحد اطرافه (نداء تونس) وظهور منزع شعبوي يغلب عليه الغموض (قيس سعيّد).
تدرّج الانقلاب
لم يكن من الطبقة السياسيّة انتباه إلى هذا التحوّل في المشهد السياسي وقواه الفاعلة. ومع حكومة المشيشي بدأت ملامح المشهد تكتمل. وظهر إلى جانب “الصراع الديمقراطي”. وهو نتيجة لأطوار تدافع القديم والجديد على قاعدة توافق بشروط القديم الفائز بانتخابات 2014 وتحت سقف المنظومة الديمقراطيّة التي بناها الجديد. ومثّل قيس سعيّد وعبير موسي هذا العنوان الجديد من الصراع المستهدف للديمقراطيّة من داخل مؤسساتها (الرئاسة، البرلمان).
في أوّل الأمر كان سعيّد محسوبًا على الجديد والصفّ الثوري رغم اختلافه النوعي عنه، مثلما كانت موسي محسوبة على القديم رغم اختلافها عن أهمّ مكوّناته نداء تونس المضمحل. ومع ذلك فإنّهما يتقاطعان في مناهضة المنظومة الديمقراطيّة في نموذجها التمثيلي باعتباره شكل انتظام تقليدي عمودي يسمح بإعادة إنتاج علاقات القوّة بعيدًا عن العدل والمشاركة المباشرة للفرد عند سعيّد، وباعتباره انقلابًا على نموذج الدولة الوطنيّة والمشروع السياسي البورقيبي عند موسي.
كانت بداية حرب الرئيس قيس سعيّد على الدستور ومرجعيّة الديمقراطيّة ومسارها. فالدستور بالنسبة إليه نصّ انبنى على ترضيات هوويّة وفئويّة طبعته بالتضارب ومن ثمّ بالتهافت. وكان لهذه التجاذبات التي نشأ فيها أثر مباشر على النظام السياسي شبه البرلماني الذي تضمّنه. وما يميّز هذا النظام من تعدّد رؤوس الدولة برغبة تجنّب مركزة السلطة في يد جهة واحدة.
سعيّد الذي كان بالأمس من بين خبراء القانون الدستوري الذين شاركوا في صياغة الدستور في لجان المجلس الوطني التأسيسي هو اليوم يناهض الدستور، بعد أن أقسم على احترامه والوقوف عند أحكامه.
أدّى هذا التجاذب السياسي في أعلى مؤسسات الدولة إلى شلل نصفي في الحكومة فصارت تعمل بنصف وزرائها حين تعطّل التحوير الوزاري . وإلى تعطّل متواصل لمؤسسة البرلمان. وكان لكلّ هذا انعكاس مباشر على الحياة الاجتماعيّة وتفاقم الأزمة المركّبة. ولعلّ أخطر النتائج كان فيما صاحب التجاذب الذي لا يتوقّف في مؤسسات الدولة الأولى من ترذيل للديمقراطيّة ويأس عام من السياسة. وبذلك اجتمعت أسباب الاحتقان والإحباط المجال الخصب لتوسّع المنزع الشعبوي وترسّخ الحاجة إلى الزعيم المنقذ.
فالانقلاب على الدستور والديمقراطيّة بدأ عمليّة متدرّجة اشتغلت على شلّ المؤسسات والحياة السياسيّة ومفاقمة الأزمة وتيئيس منهجي من جدوى الديمقراطيّة وقدرتها على بسط الرفاه والأمن والعيش المشترك.
ومثّل تاريخ 25 يونيو درجة تأزيم قصوى كانت مبرّرًا كافيًا لإعلان الانقلاب على الدستور والديمقراطيّة.
صور من الانقلاب
مضى على الانقلاب أربعة أيّام. ومن المهمّ الوقوف عند ردود الأفعال. وهي ردود أفعال متداخلة متخارجة تعكس حجم الانقسامات التي شقّت المشهد السياسي. وكان موقف النهضة الأبرز والأكثر شدًّا للأنظار لما بلغته علاقة التوتّر بين الرئيس سعيّد وحركة النهضة، وبسبب ترؤّس حركة النهضة لمجلس نواب الشعب. وكانت أكثر الصور بلاغة وأثرًا صورة رئيس مجلس نواب الشعب الرجل الثمانيني مصوحبًا بنائبته الأولى وهو يقف أمام باب البرلمان الموصد، وخلف قضبان بوابته الضخمة تجثم مدرّعة عسكريّة لتنبّه إلى أنّ البرلمان موصد بأمر من رئاسة الجمهوريّة.
وبدا التحاق نوّاب وأنصار من حركة النهضة بالبرلمان مؤذنًا برفض قاطع لعمليّة الانقلاب على الديمقراطيّة ويمثّل البرلمان مؤسستها الأصليّة.
وتتالت الردود من الأحزاب والجمعيّات والمنظّمات ومن الهيئات القضائيّة والدستوريّة والتعديليّة وكانت في أغلبيّتها الساحقة رافضة للإجراءات الاستثنائيّة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، وداعية إلى احترام دستور الثورة.
وفي سياق ردود الأفعال هذه يفهم لقاء قيس سعيّد مع أهمّ المنظّمات الاجتماعيّة. وبدا في كلمته إلى ضيوفه مبرّرًا تبرير المتراجع. فالمنقلب الفعلي لا يجعل من انقلابه موضوعًا للنقاش بقدرما يمرّ إلى تنفيد ما أعلن عنه. ولا خلاف في كون الرئيس قيس سعيّد كان يستهدف جهتين باحتجاجه على أنّ ما أتاه لا يخرج عن الدستور والفصل 80. الجهة الأولى هي المشهد السياسي التونسي وقواه السياسيّة والاجتماعيّة الفاعلة. ولن يكون مرتاحًا إلى وصف حركته بالانقلاب. ولكنّه يدرك أنّ عهودًا من نضال النخبة ضدّ الاستبداد ومن استماتتها من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحياة السياسيّة الديمقراطيّة والمشاركة في بناء تونس الجديدة ستكون حواجز عالية في طريقه إلى تصفية الديمقراطيّة التمثيليّة وفرض نموذجه الشكلاني الغامض.
والجهة الثانية هي القوى الإقليميّة والدوليّة صاحبة المصالح في تونس والمنطقة. ولا يخفى أنّ تونس تمثّل
نقطة تماسّ بين أبرز المحاور المتصارعة على منطقة المتوسّط والساحل والصحراء. وهي نقطة تتقاطع عندها مواقف هذه القوى من مسار بناء الديمقراطيّة في المجال العربي والتجربة التونسيّة باعتبارها تجربة الانتقال إلى الديمقراطيّة الوحيدة المتواصلة.
أفق الانقلاب
اعتُبر سحب النهضة لأنصارها من البرلمان تجنّبًا للمواجهة وإيثارًا للحوار طريقًا إلى التراجع عن الإجراءات الاستثنائيّة. غير أنّ الدلالة السياسيّة الأبرز لهذا الموقف هو أنّ المواجهة ليست بين سعيّد والنهضة ولا بين النهضة والشعب مثلما نجحت نسبيًّا تظاهرات 25 جويلية في إظهاره، بقدرما هو مواجهة بين الانقلاب والديمقراطيّة. وقد كان من نتائج سياسة التعفين والعجز عن الأدنى من المنجز الاجتماعي والصراع في أعلى مؤسسات الدولة استعداد طيف واسع من الناس للقبول بالانقلاب على فشل حكومة المشيشي التي تُنسب إلى النهضة دون أن تشارك فيها.
منذ إعلانه عن الإجراءات الاستثنائيّة لم يكن من سعيّد إجراءات تذكر سوى بعض الاجتماعات هنا وهناك وتبدو موجّهة أكثر إلى جمهور قيس سعيّد المدعوم بجيوش إلكترونيّة ضخمة تثير كثيرًا من الأسئلة. فجمهور سعيّد مطالب بمحاسبة الفاسدين الذين لا تخلو منهم كلمة من كلماته. ومصرّ على تجاوز المنظومة الديمقراطيّة، فهي بالنسبة إليه سبب الأزمة.
تعرف تونس منعرجًا خطيرًا يهدّد تجربتها في الانتقال الديمقراطي في ظلّ أزمة خانقة وعجز عن التجاوز لا يمكن أن يفرزا سوى نزعات شعبويّة مجنونة يسهل توظيفها في هدم محاولات تأسيس الحريّة والمواطنة من قبل قوى إقليميّة ودوليّة لا تخفي عداءها للربيع والحريّة. ولئن كان الذي يحدث في تونس يجد أسبابه في السياق التونسي إلاّ أنّه لم يكن بعيدًا عن أجندات معادية للحريّة والديمقراطيّة بقيادة الإمارات ومصر ودولة الكيان.
لم يتّخذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات كبرى منتظرة، ويبدو أنّ ما صرّح به أمام منظّمة الأعراف تغييره للرئيس المدير العام بالتلفزة الوطنيّة يأتي في إطار تأكيد الحضور لجمهوره ولكلّ من له أمل في أن يقوم سعيّد بإصلاحات جوهريّة لصالح الفقراء والمهمّشين وما وعد به من حرب على الفساد.
هذه المرّة ستكون الشروط الدوليّة هي العامل الحاسم في مستقبل تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الإجراءات الاستثنائيّة التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد. وقد أجمعت الطبقة السياسيّة والديمقراطيّة على خروجها عن الدستور وأنّ الحوار بمرجعيّة الدستور والديمقراطيّة هو السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها.
تبدو تجربة بناء الديمقراطيّة في تونس غير قابلة للكسر، بالنظر إلى النخبة السياسيّة وتاريخ الدولة وإلى عشر سنوات من الحياة السياسيّة الديمقراطيّة، وأخيرًا إلى توازنات المحاور والرهانات الإقليميّة والدوليّة الراهنة.
الترا صوت
———————–
هل هزم الربيع العربي فعلا؟/ رشا عمران
بداية بات من اللزوم بمكان الاعتراف والإقرار بهزيمة الربيع العربي وفشله فشلا ذريعا؟ إذ لم ينجح الربيع العربي في أي من الدول التي كان يفترض أن يزهر بها منذ عام 2011، تنحى رؤساء، وقتل آخرون، واستشرش بعضهم الآخر للاحتفاظ بالكرسي محولا بلاده إلى أطلال، غير أن بنية الأنظمة العربية التي حكمت على مدى عقود، كانت أشد تجذرا من أحلام وتطلعات الراغبين بالتغيير، والآملين بمستقبل لبلادهم لا مكان فيه للاستبداد ولا للإقصاء ولا للمحسوبيات ولا للفساد ولا للقمع ولا للمعتقلات.
هزم الربيع العربي، أو على الأقل الموجة الأولى منه، إذ إن التاريخ يقول إنه ما من ثورة حقيقية تنجز خلال عقد واحد من الزمن، تحتاج ثورات التغيير إلى عقود متتالية، قد تمتد إلى قرن، وسوف تمر بمراحل وافتراقات عديدة، سوف تأكل أبناءها، وسوف يغرق الدم فيها كل شيء، وسوف تتحول إلى حرب أهلية، وسوف تتنتصر مرارا الثورات المضادة، سوف تحصل الفوضى، وسوف تعود الديكتاتورية بلبوس مختلفة، سوف يقدم البشر أعز ما يملكون لأجلها ولن تكتفي، سوف تطالب دائما بالمزيد، وسوف يوجد مرارا من يعطيها المزيد، حتى تكتمل وتنجز وتهدأ وتستقر، حينها سوف يكون من بدؤوها في التراب، بينما أحفادهم هم من سيتنعمون بنعهما الكثيرة: حريات عامة وفردية، ديموقراطية، حقوق إنسان، مساواة تامة، بنى جديدة لذهنية الحكم والدولة، حرية الرأي والعقيدة مكفولة بالقانون، عدالة إجتماعية، قانون فوق الجميع، إلى آخر ما حققته الثورات في الدول التي نعتبرها متقدمة اليوم، ولنا في التاريخ الفرنسي وثورته الطويلة التي امتدت لأكثر من قرن، ولنا في الحاضر الفرنسي مثال حي وشاهد واضح على ما تكون عليه الثورات، لنا في الثورة الإسبانية على الديكتاتور فرانكو، وتحولها إلى حرب أهلية طويلة وانتصار فرانكو ثم انتصار الثورة مثل آخر.
هل هذا العرض دعوة للتفاؤل؟ هل يمكننا أن نتفاءل بناء على معطيات التاريخ؟ من وجهة نظري إن اليأس بحد ذاته هو هزيمة، لكن التفاؤل ليس انتصارا، العكس هنا ليس صحيحا، فللتفاؤل بانتصار الأحلام معطيات غير متوفرة حاليا لدينا، أقصد الأجيال التي عاصرت الربيع العربي وعاشت أحداثه وآمنت به، نحن حاليا نعيش مرحلة التخفف من ثقل جبل اليأس الذي حط على ظهورنا، ثقل الموت والقتل والتشرد والخوف والجوع والقهر والكراهية، ثقل الكشف، حيث كشفت الثورات حقيقتنا، حقيقة ما نعيش فيه من تناقض وزيف وفصام وجهل بواقعنا وواقع الآخر القريب والبعيد، كشفت حقيقة مجتمعاتنا وفسادها، حقيقة المسلمات والبديهيات التي آمنا بها، حقيقة الفساد الذي ارتبطنا به دون وعي حتى صار جزءا من شخصياتنا، حقيقة تشبهنا بأنظمتنا وممارستنا لنفس سلوكها في قمع الرأي الآخر واحتقاره وإعدام صاحبه ولو معنويا، حقيقة تعايشنا الواهي (في المجتمعات المختلطة إثنيا ومذهبيا)، حقيقة قناعاتنا المرسخة، هذا الكشف بقدر ما هو ثورة، أو أول مراحل الثورة، بقدر ما كان مفاجئا لأجيال الربيع العربي ومحبطا وقاسيا، حتى صار الهروب منه هو المطلب الوحيد، ربما هذا ما جعل البحر يمتلئ بجثث الهاربين، هو ما جعل أجيال الربيع العربي (سوريا وليبيا واليمن) على وجه التحديد تغادر بلادها دون آسف، حيث تحولت الثورات في البلدان الثلاث إلى حروب لم تنته حتى اللحظة، بينما باقي دول الربيع العربي أعادت إنتاج نفس النظام السابق.
قد يكون صحيحا أن (الدول العميقة) التي حكمت دول الربيع المستقرة، منذ عقود لم تسمح بأن تصل بلادها إلى ما وصلت إليه سوريا واليمن وليبيا، لكنها أيضا لم تسمح للتغيير أن يحدث ولو حتى لذر الرماد في العيون، بل ربما تفوقت على أسلافها بالاستبداد، وأعادت مجتمعاتها إلى حالة بؤس تنتج مظلومية متجددة وشاملة، سوف تجعل من الثورة التي حدثت مجرد طفرة تاريخية رومانسية لا يتذكرها بالخير سوى من شاركوا بها؛ ما يحدث اليوم في البلدان التي كنا نقول عنها إنها الإجابة على سؤال الربيع العربي، هو خير دليل، للأسف لم تنج دولة واحدة من هزيمة أحلام أبنائها بالتغيير، ولا واحدة، فالدولة التي لم تتلفها الحروب المتواصلة، أتلف ربيعها الاستبداد والديكتاتورية والفساد من جهة، والدين بنسخته السياسية والأصولية المجتمعية من جهة ثانية، حتى الأنتلجنسيا والنخب السياسية والفكرية والثقافية لم تستطع تقديم حل واحد ينقذ ما يمكن إنقاذه، هي نفسها على ما يبدو غارقة في نفس الخراب، ولا تملك صوابية سياسية تجاه الحدث الكبير في العالم العربي، إذ إن معظم هؤلاء النخب كانوا مع التغيير في بلادهم لكنهم يدعمون نازي العصر (بشار الأسد)، بذريعة محاربة الإسلاميين، والوقوف في وجه أميركا وإسرائيل، سيطرت على صوابيتهم الإيديولوجيا القاتلة، التي لا ترى سوى بعين واحدة، هذه العين سوف لا ترى في مجتمعاتها أيضا سوى جزء واحد، أما الآخرون فهم مجرد سقط متاع ولا مانع من إقصائهم، وللمفارقة أن سقط المتاع هذا هم الغالبية، هكذا أعادت النخب خطاب الاستبداد الذي وقفت ضده، وسلكت سلوكا زايد حتى على سلوك الأنظمة، ولم تستطع إيجاد نقطة التقاء واحدة مع باقي الشعب الذي تنتمي له، لم تستطع فهم تناقضاته ولا تشريحها ولا البحث عن حلول جذرية لها، حدث هذا أيضا في الدول التي تعيش حروبا متواصلة (سوريا واليمن وليبيا) حيث مازالت تركيبة العلاقات القبلية هي السائدة، وحيث التنوع الإثني والمذهبي يتحول إلى قنابل تستطيع الأنظمة وحلفاؤها تفجيرها في أية لحظة، في هذه الدول أيضا سقطت النخب (الثورية السياسية والثقافية) إما في فخ التعالي على المجتمع، أو في فخ الشعبوية المدمرة، وللأسف غادرت معظم هذه النخب بلادها منذ السنة الأولى لبداية الربيع، وتحول نضالها إلى نضال افتراضي، أو من انخرط في مؤسسات معارضة لم يعد يملك من قراره شيئا، بعد أن جيرت تلك المؤسسات قراراها للممولين.
أمام هذا الفشل الذي اتضح قبل أيام مع الحدث التونسي، ماذا تبقى من الربيع العربي؟ قد لا تقدم المعطيات الحالية ولو بارقة من الأمل، غير أن ثمة أجيال جديدة تنشأ وتكبر وتتفاعل مع العالم الخارجي، ولديها إمكانات تقنية ولغوية وخطاب إنساني لم يتوفر لأجيال الربيع العربي، هذه الأجيال الجديدة سواء من كان في البلاد أو من نشأ خارجها، سوف تكون هي الحامل لموجات التغيير القادمة، قد لا يحدث هذا قريبا، لا يمكن أن يحدث بكل حال إن لم يتغير ما يجب أن يتغير في بنية النظام العالمي (واهم من يعتقد أن هزيمة الربيع العربي لم تتم على يد النظام العالمي)، وهو أمر قادم لا ريب، فما تعانيه شعوب العالم بأكمله من أزمات إقتصادية مهولة، وما خلفته كارثة كوفيد 19 على البشرية، سوف يسرع في عملية التغيير العالمي حتما، وهو أيضا ما سيجعل من مجتمعاتنا جاهزة لموجات جديدة من (الربيع) إن صحت تسميته كذلك.
———————————
قيس سعيّد مصلح أم دكتاتور؟/ محمد الرميحي
كتب كثيرون عن التجربة التونسية السياسية بعد الربيع العربي معتبرين أنها التجربة الناجحة الوحيدة، وراهن كتاب ومحللون على عدد من الظواهر التي تؤيد ما ذهبوا اليه، وكنت أرى وأكتب العكس، لا لأن لدي بلورة سحرية، ولكن الفارق في أن تقرأ الأحداث قراءة عاطفية تعتمد على الهوى أو تقرأها قراءة اجتماعية سياسية (سوسيو سياسية) وتنظر الى المقدمات وتستنتج منها ما سوف يأتي.
الواضح أن التجربة برمتها كانت مبنية على أساسين: أولاً العاطفة الشديدة في ما يرغب في تحقيقه والثانية رغبات قوى سياسية ترغب في أن تتحول (من خلال النصوص)، وبشكل تدريجي، من (مكون) في المجتمع الى (مهيمن) على المجتمع.
لذلك ركبت الأحزاب المختلفة نصوص دستور 2014 المعمول به حالياً على قاعدة ضبط ما أمكن من صلاحيات رئيس الجمهورية وإطلاق اليد لكتلة وازنة في البرلمان لتكون هي قائدة العمل في الدولة. الدافع لذلك التركيب فشل إخوان مصر في تجربتهم القصيرة من جهة واعتراف “حركة النهضة” (إخوان تونس) بأنهم لا يستطيعون وحدهم الحكم من الرئاسية، فتم اختبار نظام هجين بين البرلمانية والرئاسية، زد على ذلك مجموعة تكتيكات سياسية شابها الكثير من (الزبائنية).
في الانتخابات البرلمانية اللاحقة عام 2019 لم تستطع “النهضة” أن تحقق أغلبية وازنة. فقط أقل من ربع عدد الأعضاء في البرلمان، ولو أنها المكون الأكبر، كما (فشلت وكان متوقعاً) في تعويم مرشحها بعد ذلك عبدالفتاح موروفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها قيس سعيد بنسبة كبيرة 72 في المئة. وحتى يمكن تمرير بعض الأجندة “الإخوانية” كان لا بد من التحالف الذي وجدته في قوى سياسية شبه حديثة ولكن في الوقت نفسه يشوب بعض رؤوسها فساد، وكان لا بد، وقد ملكت أغلبية بهذا التحالف، أن تتحكم بالدولة من خلال الرضا عن شخص رئيس الوزراء وإعطائه وفريقه الثقة، ومن جهة أخرى لا بد من إرضاء الحلفاء وعدد منهم يحمل ملفات قضائية وإسعافهم بالتغطية السياسة اللازمة، وإدخال عناصر من تلك الأحزاب وحزب “النهضة” أيضاً في دولاب الدولة، فتكثف القطاع العام بموظفين من دون دراية من كل تلك الأحزاب، زد على ذلك استنزاف خزينة الدولة بإصدار قانون (العدالة الانتقالية) وفي حقيقته هو تعويض من وقع عليهم الحيف إبان حكم زين العابدين بن علي ودخلوا السجون او شتتوا في المنافي، وأغلبهم من محازبي “النهضة”!
وفي سياق موازٍ، وما إنْ فشل مرشح “النهضة” في سباق الرئاسة حتى راهنت على قيس سعيّد، باعتباره وحيداً لا سند سياسياً له، وأفهم أنها قد دفعت به ضد منافسه (نبيل القروي) الذي تحالفت مع حزبه في البرلمان في وقت لاحق! واعتقدت “النهضة” أن قيس سعيد يمكن أن يدجن ويمشي في مشروعها! الواضح أن سعيد أعطاهم ذلك الانطباع، فقد بدأ بشعارات ثورية إصلاحية قريبة من تيار الإسلام السياسي، واستقبلت جماعات “الإخوان” في خارج تونس قيس سعيد بترحاب شديد ظهر في الكتابات والتصريحات لكبرائهم في عدد من العواصم التي لجأوا اليها. إلا أن سعيد لم يكن ذلك الخبر السعيد على طول الخط، وبدأ يطالب بحقوق الرئاسة كما يفهمها، وتصاعد الصدام من ناعم الى خشن كانت قمته في نهاية شهر تموز (يوليو) 2021 عندما جمد البرلمان وأعفى رئيس الوزراء وحل الوزارة، الأمر الذي استقبله الشعب التونسي بترحاب حتى الآن. إلا أن مرحلة (التشويق) أو (الانتظار) هي الفاصلة، فسعيد من الواضح أنه توسع في تفسير الفصل 80 من الدستور المصمم أساساً لتقليص قدرة الرئيس على الفعل! كما أعطى نفسه مهلاً غير واقعية في طول الانتظار أو مرحلة التشويق تعتمد على هامش صبر التونسيين، فإنْ وجدوا ما يسرهم مدوا زمن الصبر، وإنْ وجدوا ما يضيرهم قصروه!
غضب الرئيس آخذه الى فعل نصف ما يتوجب، فلا منطق في التمسك بالدستور كما كتب ونصوصه تقيد الرئيس، وبين ما تحتاجه الدولة لوضع البلاد على سكة أخرى تحتاج الى خطوات خارج الدستور!. هنا المأزق، فطول الانتظار يصب في مصلحة أعداء الرئيس وهم الآن قلّة، ولكن ربما تتوسع شرائح المتضررين ويطول انتظار الناس للإصلاح فينفد صبرهم.
نافذة الزمن ضيقة وتضيق أمام الرئيس كل ما تأخر في أخذ الخطوات الجذرية، فهو إما أن يذهب (الى دكتاتورية موقته) ويضع أمام الجمهور خطة واضحة ومقوننه بمواقيت بالتأكيد تأخذ أشهراً، أو أن يبقي الأوراق كلها قريبة من صدره متردداً، فيزداد اللغط ويضطر عنوة الى أن يعيد عمل البرلمان المجمد وهو بذلك ربما يخاطر بمنصبة وحتى بحريته.
تبين حتى الآن أن الرجل ليس (وزة ساكنة) على الرغم مما كان يبدو في البداية، إلا أن الضغط الداخلي والخارجي سوف يتزايد عليه كلما طالت فترة الانتظار التي قد تتطور من التشويق الى القلق الى المعارضة، وقتها سوف يفقد كل الأوراق التي في يده. كي تنقذ الدولة التونسية يحتاج سعيّد أكثر من الخطب، وقد يساعد إن اتخذ قرارات تصحيح المسار في كتابة الفصل الأخير في مشروع الإسلام السياسي (النسخة العربية) والذي فشل في كل محطاته العربية.
النهار العربي
—————————————-
الاستثناء التونسي على المحكّ/ منير شحود
تونس استثناء، قبل الربيع العربي وبعده، ويظهر ذلك من خلال تأثير القوانين المدنية على حياة التونسيين، وبخاصة النساء؛ حيث لم تخالف هذه القوانين الشريعة الإسلامية بقدر ما كيّفتها مع روح العصر، وساعدت تونس في التقدم خطوة مهمة على طريق فصل الدين عن المجال السياسي وعلمنة مؤسسات الدولة، وتم ذلك من خلال إجراءات حكومية دشّنها الرئيس السابق، الحبيب بو رقيبة.
يظهر ذلك التأثير بوضوح من خلال المقارنة مع جارتي تونس في الشرق والغرب، ليبيا والجزائر، مع أن هذه البلدان الثلاثة كانت قد عاشت في ظروفٍ تاريخية متشابهة، من ناحية خضوعها للحكم العثماني والاستعمار الأوروبي من بعده، واحتوائها على التركيبة الديموغرافية نفسها تقريبًا، المتمثلة بالسكان الأصليين من البربر، والقبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر الميلادي، وانتشرت في شمال أفريقيا وتركت لنا ملحمة أدبية عُرفت بـ “تغريبة بني هلال”.
وتجلّى الاستثناء
التونسي، بعد انطلاق ثورات الربيع العربي، من خلال القدرة على تجاوز أحداثه الأليمة بأقل الخسائر، والبدء بإجراءات الانتقال السياسي الديمقراطي، بخلاف ليبيا واليمن وسورية، التي ما زالت تشهد أحداثًا مأسوية، ومصر التي استغل فيها العسكر مبكرًا النقمةَ الشعبية لجزء كبير من المصريين على حكم الإخوان المسلمين، وقاموا بمصادرة الديمقراطية الوليدة عام 2013.
لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيِّد، بتعطيل عمل مؤسستي رئاسة الوزراء والبرلمان، بالاستناد إلى المادة 80 من الدستور، طرحت مسألة نجاح عملية الانتقال الديمقراطي على بساط البحث، حتى إمكانية الإطاحة بالاستثناء التونسي ذاته، ومن هنا، يمكن فهم الاهتمام الواسع بهذه الإجراءات. فهل ما حدث هو مجرد إجراء دستوري يهدف إلى مواجهة العطالة السياسية في مؤسسات الحكم، وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، أم أنه انقلاب على الديمقراطية، قد يدفع العسكر إلى تولي مقاليد السلطة في هذا البلد، في محاكاة لما حدث في مصر؟
ثمة بعض الشبه في ما آلت إليه الأوضاع في تونس حاليًا، وما حدث في مصر عام 2013 في عهد الرئيس المصري الإخواني المنتخب، محمد مرسي؛ أي كحالة انقسام شعبية حول الممارسة السياسية للإسلام السياسي في البلدين. لكن الحالة التونسية وطريقة إخراجها مختلفة، لحدّ الآن على الأقل، فقد حدث انقلاب عسكري كلاسيكي في مصر، في حين استند الرئيس التونسي إلى مادة دستورية (المادة 80) لفرض حالة استثنائية، تمثلت بتجميد عمل البرلمان ومجلس الوزراء لمدة شهر قابلة للتمديد، بمعنى إعطاء صلاحيات واسعة للمؤسسة الرئاسية، بدعم واضح من مؤسستي الجيش والأمن. يأخذ معارضو هذا الإجراء على الرئيس عدم استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان، كما تقضي هذه المادة، لكن الرئيس التونسي قال في مقابلة صحفية (30 تموز/ يوليو) بأنه فعل ذلك.
وبغض النظر عن هذه التفاصيل، فإن المشكلة السياسية القائمة في منطقتنا ما زالت تتمثل في صعوبة عملية الانتقال السياسي، الناجمة عن صراع “القط والفأر” بين العسكر والإسلاميين، فلا العسكر أثبتوا أنهم جادون في القيام بدورهم الوطني بعيدًا عن السياسة، ولا الإسلاميون برهنوا أنهم مخلصون لعملية الانتقال الديمقراطي وعلمنة الدولة، بأن ينحازوا إلى مصالح أوطانهم، بعيدًا عن ارتباطهم بالقوى الإقليمية الداعمة للإسلام السياسي.
يكمن جزء مهم من المشكلة في غموض توجهات الحركات الإسلامية، المستندة إلى عواطف دينية شعبية يمكن تجييشها بسهولة، أكثر من كونها قائمة على برامج اقتصادية – اجتماعية، وفي ميلها إلى العنف أو عدم القطع مع ممارسته، وهذا ما يجعلها مستولدة لحركات سلفية جهادية. حتى حركة النهضة، الوجه الإسلامي الأكثر عصرية، لم تسلم من اتهامات خصومها السياسيين، بالمسؤولية الجزئية عن بعض حالات الاغتيال السياسي في تونس بعد الثورة، فضلًا عن قيام أحد نوّابها أخيرًا بالاعتداء على زميلته تحت قبة البرلمان.
وتكتنف الضبابية أيضًا الحالة التنظيمية للحركات الإسلامية، كونها غير مؤطّرة ومُهيكلة كأحزاب، فهي مجرد “جماعات” أو “حركات”، ما يسهل تحوّلها الأميبي واستيلاد جماعات أخرى تابعة لها ومنفذة لسياساتها، ولكن يمكن التنصل من أفعالها حين الضرورة. لنتذكر تنصل الإخوان المسلمين السوريين من العنف الطائفي الذي مارسته الطليعة المقاتلة، إبان أحداث نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكذلك تشكيلهم، بعد الثورة، لمجموعات إسلامية من أجل ضمان هيمنتهم على المجلس الوطني والائتلاف من بعده. كما اختصر الإسلاميون في بلدان الربيع العربي مفهوم الثورة، إلى مجرد انقلاب قد يُفضي بهم إلى تولي مقاليد السلطات، وفصلوه على مقاس مصالحهم العقيدية، ما جعل خصومهم السياسيين يستنجدون بالعسكر، لا من أجل إحداث تغيير إيجابي في الواقع، بل من أجل إعادة الاستقرار إليه وحسب.
فهل التزمت حركات الإسلام السياسي يومًا بفصل الدين عن الممارسة السياسية؟ وهل عبّرت بوضوح عن أجنداتها وإخلاصها لأوطانها؟ وهل يقدّم لنا الماضي والحاضر أمثلةً عن تجارب حكم إيجابية لأحزاب عقائدية، دينية أو غير دينية؟ إن الإجابات الموضوعية عن مثل هذه الأسئلة هي ما يُزيل الشكوك حول نيّات الحركات الإسلامية في الهيمنة على السلطة، ويسحب الحجة من العسكر، الجاهزين للانقضاض على العملية الديمقراطية، وبدعمٍ شعبي لا يُستهان به؟
وبالعودة إلى التطورات الأخيرة في تونس، نجد أن من المبكر الحُكم على مآل الإجراء الرئاسي التونسي، هل سينتهي بانقلابٍ على الديمقراطية أم لا! فقد برهنت المؤسسة العسكرية على دورها الوطني، منذ الإطاحة بالرئيس بن علي، بما في ذلك حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والوقوف على الحياد في الصراعات السياسية المحتدمة منذ عشر سنوات، لكن المؤسسة الأمنية القوية والداعمة لخطوة الرئيس التونسي يمكن أن تستغلّ حالة الارتباك السياسي الحاصلة حاليًا للوصول إلى السلطة، ولو أنّ ذلك ما يزال مستبعدًا، بوجود مثل هذا الوعي الوطني والديمقراطي والدور المهم للمجتمع المدني التونسي.
تلفزيون سوريا
—————————————-
التوظيف الخاطئ للوطنية/ سلام الكواكبي
اختلفت الآراء بشكل واسع حول توصيف ما حصل يوم 25 من تموز الماضي في تونس. وقد حفلت الصحف والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن السياسي عربياً ودولياً بالعديد من التحليلات التي حاولت أن تقف عند هذا الحدث وسعت لتغطيته. ولقد وقع شبه إجماع في المواقف الدولية الرسمية على ضرورة الحذر والتنبه إلى المخاطر التي تحيق بالعملية الديمقراطية التونسية التي بني عليها الكثير من الأمل عربيا ودولياً. ولم تحسم أية حكومة غربية، إلا في الكواليس ربما، أمرها مما حصل. وما مكالمة رئيس مكتب الأمن القومي الأميركي مع الرئيس التونسي والتي استغرقت ساعة كاملة إلا مؤشر على عدم التناول الأميركي للقضية وكأنها سحابة صيف عابرة.
اللافت عربياً هو احتفال الإعلام الذي يروج علناً وبإصرار منذ سنين لتيار الثورة المضادة ليبياً ومصرياً ويمنياً وسورياً بما وقع في تونس. وعلى الرغم من هذا الاحتفال والتغطية المستمرة التي قامت بها أقنية فضائية محسوبة على أصحاب وممولي هذا التوجه الواضح للعيان والذي كتبت فيه أبحاث غربية محكمة بعيداً عن أية معايير إقليمية تترجم خلافات عربية ـ عربية، فقد أصر البعض على رفض توصيف ما وقع بأنه “انقلاب” ولو أُضيفت له عبارة “دستوري” كمحاولة ترضية وتخفيف من غلواء الموقف.
وبعيداً عن الخوض في هذا الجدال التونسي، وبالاستغناء عن الملاحظة العلمية والقانونية للأحداث، وبالتخلي عن الاستشهاد بآراء أهم الدستوريين في تونس وفي العالم الحر، يقف المتابع المهتم بمسارات الثورات العربية المجهضة أو المشلولة أو التي تعرج، أمام حائط أصمّ من “الوطنية” التونسية الرافضة لما تسميه تدخلاً في شؤون البلاد والعباد. ويجب القول والاعتراف بأن هذا النوع من “الوطنية” لا يقتصر على مجموعة بعينها وإنما يتقاسم العرب خصوصاً هذا الشعور اللافظ لأي إبداء رأي من الآخر مهما كان على علم وعلى دراية وعلى اهتمام.
في قريب الزمان، وفي اجتماع ضم باحثين من جنسيات مختلفة، “كفر” باحث برتغالي مرموق كان له باع في ثورة القرنفل وكان ولم يزل مسخراً وقته لفائدة التجارب العربية وإمكانية إغنائها بمسارات التجربة البرتغالية في التحول الديمقراطي، مما يشير بالتالي إلى سنه المتقدم، كفر إذا واعتبر أن العملية التي حصلت في مصر سنة 2013، والتي تم خلالها عزل الرئيس المصري المنتخب المرحوم محمد مرسي من قبل الجيش، هي انقلاب عسكري صريح المعالم. فما كان من باحثة مصرية مرموقة، لكنها بعمر أولاده، أن تصدت له بصراخ لا طائل علمياً منه، وصارت تلوّح بيديها في كل الاتجاهات تعبيراً عن احتجاجها على ما ورد على لسانه وكادت أن ترميه بما أتيح لها من أوراق وكتب وأقلام على طاولة الاجتماع رافضة بعنف هذا التوصيف. لم تكتف بهذا الرفض الصارخ، بل أضافت عليه كل العبارات القاسية التي يمكن أن توجه لمن يتدخل فيما لا يعنيه. وكذلك، فهي تمنت عليه، وبسخرية لاذعة، أن يهتم بشؤون بلاده ويترك مصر “أم الدنيا” لأهلها العارفين بأمورها أكثر منه. سكت الرجل المسنّ والذي تنصت لنصائحه أغلب القيادات الأوروبية. ورغم شعوره الواضح بالإهانة، إلا أن لباقته دفعته للاعتذار المخفّف وإلى التمني المعظّم. ولم تمض أشهر على هذه الحادثة إلا وكانت الباحثة نفسها في موقع وصف ما حصل بالانقلاب دون أي اعتذار أو اعتراف بخطأ التقدير.
وفي العودة إلى الحالة التونسية، فقد ظهر منذ الأيام الأولى عنف الرفض لبعض المؤيدين لما حصل، وهم كثر، لأي رأي يُبديه آخرون. فبدايةً، إن كان المخالف في الرأي من نفس المنبت الوطني، أي تونسي الجنسية والانتماء والمكوث، فهو سيصبح إما “إخونجياً” إن كان متديناً أو هكذا بدا، أو أنه عميل للغرب إن كان ضعيف التدين أو هكذا بدا، أو أنه مُباعٌ لمالٍ من دولة عربية ما أسهل لصق التهم بها. وبما أن “الانقلاب” كما يسميه البعض، أو “الحركة التصحيحية (…)” كما يسميها البعض الآخر، قد أنحى بكل المسؤوليات في انهيار الاقتصاد وسوء الإدارة وفساد الدولة على حزب النهضة الإسلامي دوناً عن بقية الأحزاب والجماعات والإدارات والسياسات بقدرة قادر، فالتهمة الأسهل هي أن الناقد هو من الإسلاميين. لكن تكمن صعوبة القرار في هذا لمطلقي التهم جزافاً عندما يتطرق مصدر فرنسي للموضوع بنظرة متشككة بعض الشيء. وسرعان ما يجد الرافضون حجة حق يراد بها باطل، وهي الاتهام بالاستشراق وبالجهل بطبيعة المجتمعات العربية والتونسية خصوصاً. وقد سهلت اللغة الفرنسية الرسمية في الأشهر الأخيرة الطريق للوصم بما تيسر من توصيفات سلبية حيث تم تصنيف جُلّ من يعمل حول الدول العربية من الباحثين بالإسلاميين اليساريين.
الشعور الوطني هو إضافة إيجابية على انخراط الإنسان في الشأن العام، ولكن تأجيجه وتحويله إلى عنصرية علمية أو إقصائية حوارية فهو أمر يصبح من القيود المعتمدة بكثرة لدى من يفقد الحجة أو لمن يشعر ـ دون أن يعترف ـ بأن موقفه ضعيف.
مع هذا “الانقلاب” أو هذه “الحركة التصحيحية” كل التمنيات لتونس وشعبها بالخير.
————————–
تونس… الفرصة الأخيرة/ خيرالله خيرالله
الى ما قبل فترة قصيرة، كانت تونس بلداً آمناً ومزدهراً. بقيت كذلك الى أن اندلعت “ثورة الياسمين” التي أطاحت زين العابدين بن علي الذي امتد عهده من خريف عام 1987 الى بدايات 2011. هل لا يزال ممكناً الرهان على “ثورة الياسمين” في ضوء التحديات التي واجهتها والتي غيّرت وجهتها؟
الجواب أنّ هناك فرصة أخيرة أمام تونس كي تستعيد مؤسساتها والقيم التي قام عليها البلد، بما في ذلك الحقوق التي تتمتع بها المرأة.
على الرغم من كلّ الأذى الذي لحق بتونس واقتصادها في أعقاب رحيل بن علي مع أفراد عائلته، لم يُفقد بعد الأمل نهائياً بالبلد ومستقبله، وذلك خلافاً لما عليها الحال في ليبيا أو اليمن. لا يمكن مقارنة تونس، بصفة كونها بين الدول التي ضربتها عاصفة “الربيع العربي”، سوى بمصر التي وقفت في وجه “الإخوان المسلمين” والتقطت أنفاسها مجدّداً في منتصف عام 2013.
تظلّ سوريا حالة منفصلة عن هذا السياق، سياق “الربيع العربي”، نظراً الى أن ما حدث في هذا البلد كان ثورة حقيقية لشعب قمعه نظام أقلّوي ما يزيد على نصف قرن، وحرمه من حدّ أدنى من الكرامة والحقوق. ستستمرّ الثورة السورية، التي مرّ عليها عقد من الزمن، سنوات أخرى. يعود ذلك الى أن الاستسلام ليس خياراً أمام الشعب السوري ولا يمكن أن يكون كذلك في ظلّ نظام فئوي لا حلول لديه لمشكلات البلد ولا يعرف سوى لغة القمع.
يحاول الرئيس قيس سعيّد حالياً إنقاذ “ثورة الياسمين” أو ما بقي من تونس، بعدما تبيّن أنّ تلك الثورة الشعبيّة التي كانت فاتحة “الربيع العربي” وقعت ضحيّة استغلال “الإخوان المسلمين” الذين تمثّلهم “حركة النهضة” التي يسيطر عليها الشيخ راشد الغنوشي ذو العلاقات المعروفة مع قوى إقليميّة مثل تركيا. لديه نهج معروف هو نهج “الإخوان المسلمين” الذين لديهم شبق ليس بعده شبق بالسلطة.
تخوض تونس معركتها الأخيرة من أجل المحافظة على نفسها. ما يجري حالياً هو فعل مقاومة يبديه المجتمع المدني في تونس الذي عاش سنوات طويلة في ظلّ مبادئ حضارية فرضها الحبيب بورقيبة الذي لم يعرف كيف ينسحب، في الوقت المناسب، من الرئاسة، ويعدّ الساحة لخليفة له يحافظ على إرثه.
ما فشل فيه بورقيبة الذي فرض نفسه “رئيساً لمدى الحياة”، فشل فيه أيضاً خليفته الذي وقع ضحيّة زوجته الثانية ليلى طرابلسي وأفراد عائلتها. لم يعرف بن علي كيف يطوّر النظام التونسي. لا شكّ بأنّه حقق، نسبياً، نجاحاً اقتصادياً. كانت مشكلته الدائمة في أنّه تصرف كضابط شرطة لا كسياسي يتطلّع الى مستقبل تونس والى نظام ديموقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. جاء رضوخه لليلى طرابلسي في السنوات الأخيرة من عهده، لينهي أي أمل بتغيير حقيقي في تونس.
من عهدي بورقيبة وبن علي، بقيت الدولة العميقة. بقيت أيضاً قوانين عصرية واقتصاد قابل للحياة مبني على الصناعات التحويليّة والسياحة والزراعة وخدمات في مجالات مختلفة. بقي أيضاً نظام تعليمي شبه معقول سمح ببروز رجال أعمال مصرفيين تونسيين مبدعين. بقيت أيضاً المرأة التونسيّة التي قرّرت الدفاع عن حقوقها. بقيت أخيراً المؤسسات الأمنيّة للدولة، بما في ذلك الجيش الذي لم يتدخّل أواخر عام 2010 وبداية 2011 كي يبقى زين العابدين بن علي وزوجته في السلطة. انحاز الجيش وقتذاك الى “ثورة الياسمين”… الى الشعب النونسي. نجده ينحاز اليه مجدّداً في أيّامنا هذه.
ليس قيس سعيّد سوى رمز للمقاومة الشعبيّة الواسعة لفكر متخلّف أراد راشد الغنوشي، الإخونجي الذي يتظاهر بالحداثة، فرضه على بلد كان واعداً. لعلّ أخطر ما قامت به “حركة النهضة” منذ إبعاد بن علي يتمثّل في حشر عناصرها في مختلف إدارات الدولة، بغية تضخيم القطاع العام الذي فقد الكثير من فعاليته وبات عبئاً على الاقتصاد التونسي.
تظاهر الغنوشي في طريق عودته الى تونس بالزهد. قال في بيان أصدره عشية سفره :”أنا عائد الى بلدي الحبيب غداً إن شاء الله، وكما صرحت في العديد من اللقاءات الصحافيّة والتلفزيونيّة، فإنّي لا أنوي الترشح لأي انتخابات رئاسية وبرلمانيّة، ولا أسعى لأي منصب. كل ما أريده هو أن أستنشق هواء بلدي الذي حُرمت منه لأكثر من عشرين سنة…”.
هذا جانب مما غرّد به الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي الحالي، الذي جمّد رئيس الجمهوريّة نشاطه في الخامس والعشرين من الشهر الماضي موقتاً، كي يوقف المسرحيّة الهزلية التي شهدها البرلمان على حلقات في ظلّ رئاسة الغنوشي له.
ثمّة أمل في تجاوز تونس محنتها. يعود الفضل في ذلك الى عوامل كثيرة. من بين هذه العوامل إدراك الشعب، بأكثريته، أن هناك فرصة أخيرة متاحة من أجل إنقاذ البلد. ما حدث يوم 25 تمّوز (يوليو) 2021 لم يكن “انقلاباً” كما يدّعي الغنوشي وآخرون. ما حدث كان سعياً الى استغلال الفرصة الأخيرة المتاحة كي تعود تونس الى أهلها ولا تتحوّل الى ليبيا أخرى أو الى يمن آخر…
النهار العربي
———————————–
جردة الحساب/ أسامة رمضاني
تساءل العديد من المتابعين الأجانب للشؤون التونسية عن السبب الذي جعل الاعتبارات القانونية والدستورية تغيب عن أولويات التونسيين في ردود فعلهم على قرارات الرئيس قيس سعيّد التي اتخذها في 25 تموز (يوليو) بإعفاء رئيس الحكومة من مهماته وتعليق صلاحيات البرلمان وإلغاء الحصانة البرلمانية لأعضائه.
بقي الجدل العام إلى حد كبير محدوداً حول ما إذا كانت مبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور تشكل “انقلابا” أم لا. بل إن الرأي العام في تونس فضّل إعطاء فرصة لسعيّد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساندته بأغلبية كبيرة لا مجال للشك فيها للقرارات التي اتخذها في 25 الشهر الماضي.
كانت ردود الفعل في الواقع بمثابة جردة حساب. جاءت بعد أن سئم أغلب الناس تصرفات الطبقة الحاكمة بمؤسساتها وأحزابها وشخصياتها. سئموا إمعانها في المناقشات البيزنطية حول الصلاحيات والغوص في فقه القانون الدستوري والقانون الداخلي للبرلمان في ما تغرق البلاد في الوهن والتفكك وينحدر اقتصادها نحو التداعي ويرتفع عدد مرضى كورونا بما يتجاوز طاقة الأطباء والمستشفيات. يئسوا من قدرة البرلمان أو حتى استعداده للمساعدة على إخراج البلاد من أزماتها المتراكمة. وتنامت القناعة بأن الحكومة مصرّة على قراراتها العشوائية التي تنم عن انعدام كفاءة وقلة وعي بأن صبر الناس قد نفد.
لم تكن هناك أية مفاجأة في تظاهرات الشوارع والدعوات إلى الاحتجاج التي لم تتوقف عبر الشبكات الاجتماعية. ولكن المفاجأة الحقيقية كانت في بطء ردة الفعل رغم علامات الفشل الحكومي واتساع الهوّة بين الشباب والطبقة السياسية… شباب ليس من شيمه الصبر غير المحدود أو الرضى بدور هامشي في انتظار الانتخابات المقبلة. لم يعد بوسع الشباب (وحتى الجمهور الأكبر منهم سناً) أن يلتزموا موقف المشاهد في الوقت الذي كانت فيه النخبة الحاكمة تقدم كل يوم مزيداً من البراهين على أنها عاجزة عن مراجعة نفسها من أجل إنقاذ البلاد أو حتى على تخفيف سرعة الانهيار.
كانت أخطاء الحكم في الأسابيع والأشهر الأخيرة فادحة وصادمة. حكومة نسيت أن تستجلب لقاحات كوفيد في الوقت المناسب واختار بعض أعضائها أن يقضي عطلة الصيف في المنتجعات في حين ينتشر المرض والموت في البلاد. كان هناك كلام من محافظ البنك المركزي عن صدمة شديدة آتية سيحدثها تدحرج الاقتصاد إلى القاع. ومشاهد عبثية في مجلس نواب الشعب بلغت حد العنف الجسدي.
قد لا يفهم المنظّرون الأجانب، الذين علّقوا آمالهم النظرية على رمزية الانتقال الديموقراطي في تونس (الفائز بجائزة نوبل للسلام) ما يحصل في أيقونة “الربيع العربي”. غفل معظمهم عن أن المسارات الشكلانية لم تعد تهم المواطن البسيط بقدر ما كانت تشغله أسباب الأداء الفاشل واستشراء الفوضى والفقر والبطالة ويتملكه الخوف من الغد الآتي على عجل.
المواطن البسيط نفسه أصابه الكلل من صراعات السياسيين على السلطة ومن المبررات الدستورية والقانونية التي يسوّقونها لتبرير ضياع السفينة إذ تتقاذفها الأمواج ويمسك بدفتها أكثر من ربان.
في ردة الفعل الشعبية كان هناك أيضاً رفض لفشل الحكومات في إدارة الأزمات ولتفريطها في هيبة الدولة وسلطتها من خلال سياسات داخلية وخارجية وصلت حد تعريض الأمن القومي للخطر.
في الأثناء، أضاع كثير من الأحزاب خصوصاً تلك التي اضطلعت بالحكم وقادته إلى خيباته، وعلى رأسها “حركة النهضة”، جانباً كبيراً من قواعدها ومن صدقيتها لدى أنصارها قبل غيرهم. ولم تعد الوعود الحزبية ولا سرديات التشكي من ممارسات الحكومات والعهود السابقة تجدي نفعاً بعد عشر سنين من مؤشرات التهاوي. ولم يعد التنميق اللغوي يجدي بعدما اكتشفه الناس من ممارسات المحاصصة والولاءات الحزبية والأيديولوجية على حساب الكفاءة ومصلحة الوطن.
ما يحدث اليوم في تونس هو إلى حد كبير نتيجة فشل الأحزاب الحاكمة في وضع استراتيجيات للتسيير وإدارة الشأن العام خارج نطاق التنافس المحموم على السلطة والجري وراء اقتناص الغنائم.
الغريب لم يكن فقط طغيان الجشع والانتهازية بين أهل السياسة إنما نسيانهم أن المجتمع التونسي قرية صغيرة لا يخفى على أهلها شيء. كل فرد فيها يكاد يمسك معجماً لإعلام السياسة ويملك آلة كاشفة لنواياهم. والجميع يعرف المقدار الحقيقي لحرص الشخصيات الفاعلة على مصلحة البلاد مقابل المنفعة الخاصة أو العكس.
ليس واضحاً إن كانت هذه الأحزاب قادرة اليوم على القيام بمراجعات حقيقية لسياساتها خصوصاً تقييم دور الشخصيات الفاعلة فيها بعد تجربة العشر سنوات الأخيرة. فقد يكون الوقت ملائماً للبعض من الفاعلين الفاشلين، وهم كثيرون، أن ينسحبوا ويبحثوا عن شيء آخر غير بيع السراب وزرع بذور الفشل.
في غياب خريطة طريق لما ينوي قيس سعيّد تحقيقه خلال فترة تطبيقه للأحكام الاستثنائية وما بعدها، ما زالت ملامح ما ستكون عليه الأوضاع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة غير واضحة، وإن كان كثيرون يتوقعون أن تتولّد عن الأزمة الحالية مبادرة رئاسية لتنقيح القانون الانتخابي ونظام الحكم (ولو عبر استفتاء) من أجل العبور إلى انتخابات، سابقة لأوانها قد توفر مشهداً سياسياً جديداً أكثر استقراراً.
لا يمكن لصاحب القرار في تونس التغافل في الأثناء عن عامل الوقت الضاغط، وهو عامل محدِّد بخاصة بالنسبة إلى الأزمتين الصحية والاقتصادية وتبعاتهما الاجتماعية.
ويبقى هناك أيضاً العامل الخارجي بكل تناقضاته وتجاذباته، وهو العامل الذي ليس في إمكان تونس أن تتجاهله مهما يكن حرصها على سيادة قرارها وعلى توضيب أوراقها في الداخل أولاً.
وبالفعل فإن العامل الرئيسي الذي قد يشكل التحدي الأكبر يبقى داخلياً ويتعلق بتطلعات الشباب ومواصلة ضغطه من أجل قرارات تستجيب لطموحاته.
أظهر هذا الشباب في تظاهراته واحتجاجاته ما يكفي من الوعي للدفع سلمياً نحو التغيير والإصلاح. وذلك يمكن أن يجعل منه خير حليف لمن يتحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد بشكل رشيد ويقدر على استخلاص العبر من الفرص الضائعة في الماضي القريب.
لم يعد التعايش مع نبض الشارع خياراً في الحياة السياسية التونسية. منذ أكثر من عقدين لم يعد التونسيون مستعدين للقبول بمن يضيّق على حرياتهم أو يمنع احتجاجاتهم. صار محتماً نزولهم إلى الشارع كلما ضاقت بهم السبل أو انسدت آذان الحاكم. ومهما كانت التضييقات فهي لن تمنعهم من التعبير عن رفضهم لأخطاء السلطة إن هي سلكت طريقاً يزيغ مجدداً عن مصالح الأغلبية.
ولكن الأجيال الصاعدة تبقى أيضاً طاقة حية يمكن أن تشكل قاطرة المجهود الوطني نحو إعادة تركيز بنية سياسية سليمة واقتصاد يعمل حتى وإن كانت الطريق إلى ذلك تبدو اليوم طويلة.
—————————-
======================
تحديث 05 آب 2021
————————
تونس: إزالة آثار العدوان!/ بكر صدقي
كان هذا الشعار نوعاً من «برنامج عمل» القيادة الناصرية في مصر بعد هزيمة حزيران 1967، وقد لاقى ما يستحقه من استهجان في الرأي العام المصري والعربي. فقد كان يهدف إلى التهرب من استحقاقات الهزيمة، وفي مقدمها اعتراف تلك القيادة بمسؤوليتها عن الهزيمة العسكرية وبوجوب خضوعها للمحاسبة الشعبية وتقديم استقالتها، بدلاً من التمسك الذليل بالسلطة بذريعة أن «العدوان الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه» المتمثل في إسقاط النظامين «التقدميين»! في مصر وسوريا كما كانت وسائل إعلام النظامين تروج.
تذكرت هذا الشعار وأنا أتابع الأخبار المقلقة القادمة من تونس بعد القرارات الانقلابية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، فأقال الحكومة الشرعية وعطل عمل البرلمان، متذرعاً بالصلاحيات الاستثنائية التي قال إن الدستور زوده بها. فهذا الإنقلاب الذي يذكر بانقلاب الثالث من شهر تموز 2013 في مصر هو نوع من إزالة آخر أثر لثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس نفسها في أواخر العام 2010، وامتدت إلى عدد من البلدان العربية، ثم انتكست تباعاً من خلال إغراقها بحروب دموية وتدخلات عسكرية خارجية بهدف القضاء على فكرة الثورة بالذات.
فبعد هزيمة جميع تلك الثورات، من ليبيا إلى اليمن فمصر فسوريا، بقيت تونس التجربة الوحيدة الناجحة في تلك السلسلة، على رغم كل المشكلات التي اعترت الحياة السياسية في تونس، وفشل النخب السياسية في وضع الأمور على سكتها للمضي قدماً إلى الأمام. وهكذا كان على قوى الثورة المضادة أن تكمل مهمتها في الإجهاز على التجربة الديمقراطية في تونس بعد نجاحها في ذلك في دول الثورات الأخرى. فنجاح التجربة التونسية، حتى لو شكل استثناءً، يعني أن فكرة الثورة على أنظمة الحكم البدائية الفاشلة سوف تستمر في إلهاب حماسة الناس، كما حدث فعلاً في لبنان والعراق والجزائر والسودان فيما سمي الموجة الثانية لثورات الربيع العربي بين 2018 ـ 2019. لذلك كان لا بد من إسقاط التجربة التونسية.
هذا لا يعني بحال أن تونس كانت في أحسن أوضاعها، فتدخلت القوى الخارجية المضادة للثورات لتفتعل مشكلة بلا أساس. فعوامل الأزمة السياسية في تونس داخلية أساساً، وقد ارتفع منسوب التذمر الشعبي من فشل النخب السياسية في حل مشكلات البلاد إلى درجة عالية. وهذا ما أضفى على قرارات الرئيس سعيد شيئاً من المشروعية الشعبية. هذا خطر بحد ذاته، فهو يعيدنا إلى فكرة «المنقذ» الذي يضرب الطاولة بقبضته و«يصحح المسار». أليست هذه الفكرة هي أساس كل انقلاب عسكري قضى على الحياة السياسية بذريعة «تصحيحها»؟
الجديد في الأمر هو أن قيس سعيد ليس عسكرياً كعبد الفتاح السيسي، ولا سند عشائرياً له كصدام حسين أو علي عبد الله صالح. فأساس شرعيته الوحيد هو الناخب التونسي الذي جاء به إلى السلطة بنسبة عالية من الأصوات، ويسند مشروعية قراراته الانقلابية إلى التذمر الشعبي من الطبقة السياسية. في هذا إنما يختلف انقلاب سعيد عن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في تموز 2013 في مصر. ربما يمكن إطلاق وصف «الانقلاب المدني» على ما يقوم به سعيد في تونس. شاع استخدام هذا التعبير الغريب في الرأي العام التركي، بعدما اتضحت الميول السلطوية للرئيس أردوغان قبل سنوات. فتركيا ذات التاريخ الحافل بالانقلابات العسكرية، الناجحة منها والفاشلة، محكومة من حزب العدالة والتنمية بصورة متصلة منذ 19 عاماً، وبلا أي إخلال بالنظام الديمقراطي القائم على تداول السلطة بانتخابات دورية. طرحت الكاتبة السياسية المعروفة «نوراي مرت» تعبير «الانقلاب المدني» قبل سنوات، في وصف التوجهات السلطوية المتصاعدة، فووجه اقتراحها بانتقادات شديدة. لكنه بمرور السنوات أخذ يلاقي رواجاً أكبر باعتباره أداة تفسير معقولة للحالة السلطوية القائمة.
غير أن ما أسميه بقوى الثورة المضادة تستثمر أساساً في مشكلات داخلية موجودة، فتبني عليها وتعزز مفاعيلها باتجاه إفشال ثورات الربيع العربي. هذا ما أسميه بإزالة آثار العدوان من وجهة نظر هذه القوى المضادة. فثورات الربيع كانت، في نظرها، بمثابة «عدوان» على استقرار تلك الأنظمة واسترخائها اللذيذ، جعلها في حالة هلع على مستقبلها، ثم انتقلت من حالة الدفاع إلى الهجوم بعدما انكشفت نقاط ضعف العدو (أي الثورات) فاستثمرتها إلى أقصى الحدود. ذلك أن نجاحها المحتمل في هزيمة تلك الثورات من شأنه أن يعيد إلى الواجهة نظرية «الاستثناء العربي» التي يمكن ترجمتها بصورة فظة بعبارة إن «الشعوب العربية لا تستحق الحرية» أو لم تنضج بما يكفي لتحكم نفسها بنفسها، وذلك «لأسباب ثقافية» خاصة بها!
بهدف تدقيق العبارة المنسية كتبت على محرك البحث غوغل عبارة «إزالة آثار العدوان» لأتأكد من أن هذه هي الكلمات الصحيحة للشعار القديم. وإذ بي أجد في أول قائمة الروابط مقالة منشورة في صحيفة الأهرام المصرية بالعنوان نفسه، وعن الحدث التونسي بالذات! فقد كتب مرسي عطا الله مقالة من جزأين بعنوان «ما أشبه الليلة بالبارحة» والعنوان الفرعي للجزء الثاني «إزالة آثار العدوان» شبه فيه قرارات قيس سعيد بـ«قرارات» 3 تموز 2013 في مصر، وختم مقاله بالأسطر التالية:
«ظني أن صحوة التونسيين من كابوس ثقيل جثم على نفوسهم وصدورهم نحو 10 سنوات تمثل أقوى ضمانات النجاح لمسيرة التصحيح التي لن تتأثر بالصراخ والصخب الذي يحاول الغنوشي اللجوء إليه داخل وخارج تونس هذه الأيام!»
كاتب سوري
القدس العربي
——————————
هل تطيح شعبوية قيس سعيّد النظام السياسي؟/ عمار ديوب
جاء من خارج الحياة السياسية. لم يعط أهمية لمؤسسات الدولة الأساسية، كمجلس الوزراء، وقد عطّله، ومجلس الشعب، ولم تعجبه المكابشات فيه. خشيته من أن تُرفض قراراته أو تُحجَّم سلطاته منعته من التوقيع على قانون لتشكيل المحكمة الدستورية العليا، فتعطّل دورها التحكيمي في الفصل بين السلطات وتحديد مهامها ومنع التداخل بينها، والتحكيم بينها حين تستعصي المشكلات. صار الرئيس التونسي هو المفسّر للدستور وللقوانين، والآن يريد أن يكون هو المنفذ والمراقب والقاضي كذلك! مقابل تهميشه دور مؤسسات الدولة المدنية، عزّز علاقته مع المؤسسات “القمعية”، وجاء انقلابه مدعوماً منها، ومحاطاً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين. إذاً أجرى قيس سعيّد انقلاباً على مؤسسات الدولة، وخالف حتى القانون الذي افترض أنه يعطيه الإذن بذلك. هذا ما قاله كبار الدستوريين، وفي مقدمتهم عياض بن عاشور، وأن سعيّد خالف المادة 80 من الدستور شكلاً وجوهراً.
استند سعيّد كذلك إلى الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، وانخفاض قدرة وزارة الصحة والمؤسسات المرتبطة بها على مواجهة جائحة كوفيد 19، وازدادت خطورتها أخيرا بشكل حاد. ليس هناك من خطرٍ داهم ليقيم الانقلاب. المشكلة الحقيقية في تونس عدم قدرة النظام السياسي على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وغرقه في مناحراتٍ في مجلس النواب وتعطيل تشكيل الحكومة، ولقيس سعيّد ذاته دورٌ في هذا. قام النظام السياسي التونسي على المحاصصات بين الكتل الأقوى، ولا سيما حركة النهضة، والاتحاد العام للشغل، ورأينا التحاصص بين الباجي السبسي وراشد الغنوشي، والذي كان له أثر سيئ على عدم إيجاد مداخل حقيقية لمشكلات تونس المذكورة. أي أن الأزمة السياسية تلك هي التي أوصلت قيس سعيّد إلى الرئاسة، حيث هناك تضرّر اجتماعي كبير من الخلافات في مجلس النواب، بينما الناس ينتفضون وينتفضون، وليس من نهاية للأزمة التي هم فيها.
حصل الانقلاب، فما العمل؟ سيحاول قيس سعيّد وضع كامل السلطات تحت يديه، وبذلك يقيم الأساس الأوّل لديكتاتورية مستمرّة. مشكلته هنا بالضبط. نعم، لقد ناصرته قطاعاتٌ شعبيةٌ كبيرة حين ترشّح وانتُخب، والآن هناك قطاعات شعبية واسعة تؤيده كذلك، وتتكوّن بأغلبيتها من الفئات المهمشة والعاطلة من العمل، ومن غير المنخرطة بالعمل السياسي. يشار هنا إلى أن أغلبية القوى السياسية، ليبرالية، ويسارية، وأبرز الفاعلين في الوسط الثقافي رفضت الانقلاب وسمته كذلك.
الآن الرئيس معزول تقريباً، وهو بالأصل لا يرى الطبقة السياسية إلّا فاسدة وفائضة عن الحاجة، ويجب محاكمتها. هذا يعني أنه سيشكل حكومةً من تكنوقراط، أو حكومة من شخصياتٍ موثوقة، وستتبوأ إدارة الدولة بعض الوقت. وهنا نحن أمام خيارين، تمديد إضافي لتجميد البرلمان أو الإعلان عن انتخابات نيابية مبكرة، وهذا لن يتحقق، باعتبار أن الرئيس يطمح إلى تغييرٍ كبير في النظام السياسي، ويبدو أنّه يريده رئاسياً بامتياز، وللدقة ديكتاتورياً. سيشكل حكومة لمعاونته في إدارة شؤون الدولة، وسيكون هو المسيطر عليها، وحينها ستتضح له فعلياً مشكلات تونس، وسيجد نفسه، وقد أخفق هو، وحكومته، أنه أمام مظاهرات اجتماعية عنيفة.
يُفترض بالقوى السياسية الرافضة للانقلاب تشكيل جبهة متّحدة، ويفترض ألا تكون بقيادة حركة النهضة، حيث هناك تململ شعبي من دورها منذ 2011، وتراجع عدد المنتخَبين منها برلمانيا يوضح هذه الفكرة. وأيضاً لعب التصعيد في البرلمان بين الحزب الدستوري الحر ونواب “النهضة” دوراً في تحميلها التأزم المتعدّد الأوجه الذي تعاني منه الدولة. عدا ذلك، هناك تهميش لدور الإسلام السياسي في المنطقة أكثر فأكثر، وليس كما قيل إن الإدارة الأميركية ستعيد لهم دوراً في الأنظمة السياسية العربية، كما كان الأمر في زمن الرئيس أوباما.
الجبهة الجديدة، وقد فَرض عليها سعيّد التشكل، معنية بالابتعاد عن خوض النضال ضد الديكتاتورية من زاوية أنها تمثل الديموقراطية المنتخبة المؤودة، وضد الديكتاتورية المستحدثة. ليس هذا المدخل المناسب لتفعيل دور الشعب التونسي وقواه السياسية والفكرية والأدبية وإيقاف مغامرة الرئيس. المدخل هو تقديم برامج سياسات إنقاذيه للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتظاهر تحت يافطة شعارات متعدّدة الدلالات، وتبدأ بالاجتماعي والاقتصادي.
سيستفزّ قيس سعيّد الآن القوى الرافضة له، وسيبدأ بشكلٍ مركز حملاته ضد حركة النهضة، فهي، وعلى الرغم من تراجع شعبيتها، ما زالت القوة الكبرى في البرلمان، وهي أكثر القوى السياسية تنظيماً. وبالتالي سيعمل على تحطيمها بشكل كبير. نموذجه في ذلك عبد الفتاح السيسي. دلّ إنهاء حركة النهضة الاعتصام أمام مجلس النواب على تفكير عقلاني، فالقضية لا تتحدّد بخسارتهم هم الحكم، بل بخسارة تونس التجربة الديمقراطية، وفي تعطيل الحياة السياسية برمتها، وإدخال البلاد في المجهول، وهذا ما يستدعي تشكيل الجبهة المتّحدة.
من الضرورة التمييز بين مصر وتونس، فالأخيرة لم يُعرف عن جيشها تدخل بالسياسة، وهو لا يمتلك اقتصاداً قائماً بذاته، كالجيش المصري مثلاً، ودعمه الرئيس الحالي مرحلي، سرعان ما سيستفيق على خطورة دوره في تأييد رجلٍ يتوهم نفسه ديكتاتوراً، وأنه فوق السياسة، ويعرف أهواء الشعب، وأنه الممثل الوحيد عنه. ليست مشكلة تونس في عدم قدرتها على مواجهة جائحة كورونا، بل في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت الحكومة تتجه نحو اقتراض دولي لإدارتها وليس لحلها، فكيف سيتمكّن قيس سعيّد، والذي ترفضه أغلبية القوى السياسية الوطنية، وتحذر من ديكتاتوريته بيانات حقوق الإنسان، وسواها. .. المقصد هنا أن الرجل لن يجد من يقرضه إلا الإمارات، وربما السعودية، وهذا لن يكون بلا أثمان كبيرة، فماذا تمتلك تونس لتعطيه لهذه الدول؟
إنهاء ثورة تونس هو الهدف من الانقلاب. سيكتشف “الجنرال” قيس سعيّد بدوره أنّه أغرق البلاد في فوضى كبيرة، حيث من الصعب أن يطيعه الجيش طاعةً عمياء، فالجيش التونسي أقرب إلى الجيش اللبناني، وهذا يعني أن قدرته محدودةٌ على إشادة ديكتاتورية. الحل الأسرع للخلاص مما ورّطه فيه قيس سعيّد استلام الحكم والإطاحة بقيسٍ نفسه، والإعلان عن انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومةٍ مؤقتةٍ لإدارة شؤون الدولة. لن يستفيد الرئيس من شعبويته كثيراً، ولن يظل الجيش طويلاً في خدمته، ومن هنا سيكون تشكيل جبهة سياسية موحدة، وليس بقيادة حركة النهضة، وتعكس مطالب الشعب، أهم رد عملي وسياسي لإيقاف تأسيس الديكتاتورية في تونس.
الجبهة المتحدة ستراها قيادة القوى العسكرية والأمنية جيداً، وستّتجه نحوها من أجل إنقاذ النظام السياسي المأزوم بحق في تونس. لن ينجح قيس سعيّد في طموحاته، ولكن لن يعطي الشعب مجدّداً ثقته بقوى سياسية لا تحدّد له خريطة طريق واضحة، وببرنامج زمني محدد لإخراجه من أزمته الاقتصادية والاجتماعية.
العربي الجديد
————————
بهجة الديكتاتورية وسعادة العبودية!/ حسام الدين محمد
أتذكر في بداية شبابي في بيروت مجلة فريدة من نوعها كونها كانت تنظَر للماركسية بأسلوب غير اعتيادي يبشر بولادة «الإنسان اللاعب» الذي يرفل في جنة الشيوعية. كان يحرر المجلة كاتب تونسي يدعى الصافي سعيد وقد حيرني، حينها، بأنه كان يوقع بعض ما يكتبه باسم «صاحب الحمار».
التقيت الكاتب الليبي إبراهيم الكوني بعد ذلك بسنوات طويلة، وتعرفت على رواياته التي تستلهم حكايات الطوارق /الأمازيغ في الصحراء الكبرى، وكتبت عن بعضها كـ«التبر» و«المجوس» وشرح لي حينها قصة «صاحب الحمار» الذي هو رجل دخل بلدة على هيئة شيخ جليل يركب حمارا، وفتن أهل البلدة بأحاديث عن كنوز طائلة في مدينة «واو» الأسطورية فتبعته البلدة برجالها ونسائها وأطفالها حتى أودى بهم في هوة فاغرة التهمتهم جميعا.
قضى الصافي عمرا في الصحافة والسياسة، أسس خلالها مجلات «وعي الضرورة» (المذكورة سابقا) و«رواق 4» و«أفريكانا، وترشح للنيابة عام 2011، وللرئاسة في انتخابات عام 2014 و2019، وهو الآن نائب في البرلمان الحالي «المجمد» وقد تابعت له مواقف مؤخرا يصف ما حصل في تونس مؤخرا بـ«شبه الانقلاب». رغم نقده للحكومة المقالة، التي كان قد سماها «حكومة دفن الموتى» وللبرلمان الذي اعتبر أنه صار مهزلة ومسرح كارتون، لكنه وضع أيضا نقاط استناد منطقية لتفنيد حركة قيس سعيد، حيث قال إن الجميع منتخبون وكلهم مسؤولون عن الفشل الحالي، وبالتالي كان على سعيد، لو أراد أن يكون عادلا على غيره ونفسه، أن يدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية لا أن يجمد البرلمان، من دون استشارة أحد، ولا اعتماد على الدستور ومفاصله، ومن دون ضمانات، ولا معرفة من سيحكم ويسير البلاد.
رقص الجمهور للانقلابات
تبدو هذه النقاط عند سردها عقلانية ومنطقية، وقد نشر عدد من الكتاب والصحافيون العرب، تحليلات وآراء ضمن سياق النقد التاريخي والسياسي والأدبي للانقلابات العسكرية، بالاستناد إلى أمثلة قريبة، من مصر، وأخرى من بلدان عربية وأجنبية، وبتفنيد طروحات سعيد، غير أن هذه الآراء جوبهت بتحليلات من كتاب آخرين تؤيد صراحة أو بشكل ضمني حركة قيس سعيد، وقوبلت الانتقادات حركة سعيد بردود غاضبة من جمهور تونسي وعربي، كما ظهرت أشكال جماهيرية من التأييد لسعيد، بما فيها أغنية بعنوان «انقلاب» يؤديها مغنو راب توانسة يتغنون بما فعله الرئيس.
عرضت في مقالة سابقة لي كتابا نادرا لصحافي مصري يدعى لطفي زكريا سجل فيه انطباعاته عن الانقلابات الأولى المتلاحقة التي جرت في سوريا منذ عام 1949، ونشر في ذلك الكتاب تفاصيل عن ردود الفعل البائسة التي تورط فيها ساسة وصحافيون بتأييد الانقلاب، كما أشار إلى مشهد لفت انتباهي منذ قراءتي قبل قرابة 30 عاما لذلك الكتاب، وهو مشهد سوريين عاديين رقصوا في الشوارع بهجة وتأييدا للانقلاب. فتح الكتاب المذكور أمامي بابين عريضين للبحث: الأول يتعلق بتفسير بهجة الجمهور بصعود عسكري يبطش بالساسة الحكام (ثم بهم أيضا) والثاني يتعلق بمواقف النخب السياسية والصحافية التي تستطيع أن ترى الكوارث التي تفتتحها الانقلابات العسكرية، كما فعل لطفي زكريا ومحمد حسنين هيكل (الذي كان موجودا أيضا لتغطية الانقلاب السوري وشارك في تهريب أحد المطلوبين من السلطات) لكن عندما يحدث ذلك في بلدها لا تلبث أن تأخذها الحمية (أو المصلحة والانتهازية) فتكرر، بعد وقوع انقلاب 1952، ما فعله الصحافيون السوريون، وتكرر الجماهير المصرية ما فعلته الجماهير السورية.
سادت صفحات الجرائد والمجلات المصرية بعد عام 1952، كـ«الأهرام» و«الهلال» و«روز اليوسف» و«الرسالة» و«المصري» وغيرها، موجة من التهليل الكبير بالحركة العسكرية والهجاء للنظام القديم، فقال أحمد حسن الزيات، رئيس تحرير «الرسالة» في افتتاحيته بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 1953 «من عهد إلى عهد» على سبيل المثال: «غلت صدور الضباط الشباب من الحمية والحفيظة، فأخذوا ذلك الملك الماجن من قفاه الغليظ وألقوه في البحر، وقبضوا على حاشيته الفاجرة وطرحوهم في السجن، وأدبوا الساسة الريبين وحجزوهم في المعتقل، وركلوا الموظفين المجرمين ورموهم في الشارع».
لماذا أغلق أحمد أمين مجلة «الثقافة»؟
من جهة أخرى، وكي نكون منصفين، فقد تمايز بعض الساسة والمثقفين والإعلاميين عن جمهور المرحبين وضجيج التأييد لجمهور الراقصين للضباط المستولين على السلطة، وقد حصل ذلك في سوريا، كما حصل في مصر، ولا يمكن، في هذا السياق، عدم ملاحظة توقف مجلتين مثل «المقتطف» التي كان يرأس تحريرها يعقوب صروف، وأن يختم أحمد أمين، آخر عدد أصدره من مجلة «الثقافة» في الشهر نفسه الذي قامت به حركة «الضباط الأحرار» بمقالة بعنوان «قلة المروءة» يقول فيها: «يمتاز عصرنا هذا بقلة المروءة» ويتابع: «كانوا يحدثوننا عن القديم بأنواع من المرويات يضحي فيها الرجل بنفسه أحيانا، وبماله أحيانا، حتى لتستخرج منا العجب. فيحدثوننا أن الشرطي العباسي أتى ليقبض على عبد الحميد الكاتب فوجده مختفيا عند صديقه ابن المقفع، فقال أيكما عبد الحميد، فكل منهما قال أنا، وكل منهما يعلم أنه إنما حضر الشرطي ليقتل عبد الحميد، ونحن اليوم لا نفهم هذه القصة لأننا لا نفهم معنى المروءة».
يروي غوستاف لوبون في كتابه «سايكولوجية الجماهير» حادثة عن مجموعة جنرالات ذهبوا للقاء جنرال «انتهازي صغير» ـ على حد رأيهم – أرسلته باريس فقام ذلك الجنرال، الذي لم يكن غير القائد الفرنسي العظيم نابوليون، بتركهم ينتظرون فترة طويلة قبل أن يستقبلهم ثم ظهر عليهم مزنرا بسيفه ولابسا رداءه وشرح مواقفه وأعطاهم الأوامر وصرفهم! يحذر لوبون في كتابه ذاك من «تقديم النصح للجماهير» قائلا: إياك أن تدخل معهم في جدل منطقي، وإياك أن تطلب منهم التعقل أو الوعي، وفي استشهاده بنابوليون يحكي كيف ظلت الجماهير الفرنسية تصفق له حتى وهو يلغي الحريات، ويحكم بيد من حديد، رغم أنه جاء بعد ثورة قدمت الكثير من التضحيات إلا أنها قبلت من نابوليون أن يحكمها بأساليب الطغيان التي مارسها الملك الذي انقلبت عليه وقطعت رأسه!
ليس الخداع أحد العناصر المكوّنة للجنس البشريّ فحسب، بل هناك حاجة وجودية لدى الإنسان، للانخداع والإيمان بحكاية حتى لو كانت ستؤدي إلى ضرر له، ولعل الإشكالية الكبرى في هذه الظاهرة الإنسانية ليست بالانخداع بـ»صاحب الحمار» الذي سيسلبنا حرياتنا، ويحوّلنا إلى عبيد، لكن في إصرار البعض على الهبوط إلى الهاوية الفاغرة مع العمل على إقناعنا أنها فردوس خلاب، بل إن بعض من توفّر لهم الأقدار فرصة النجاة من تلك الهوة، يعودون، بعد تكبّدهم الأهوال للنجاة، للانخداع مجددا، بل وللدفاع عن الشيطان الذي أودى بهم إلى الهاوية.
كاتب من أسرة «القدس العربي»
القدس العربي
——————————-
تونس: من أين يأتي هذا الخراب؟/ بدر الشيدي
في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ظهر شخص عربي في ميدان مكتظ بالمتظاهرين، تبدو على الشخص أمارات من البؤس والتمزق والتوهان، ولما سأله أحد الصحافيين عن ماذا يتوقع، ظل الرجل تائها فاغر الفم مندهشاً، يتلفت في الاتجاهات المختلفة، بينما الأصوات تملأ الأفق، قال رداً على السؤال: هو فيه أيه.. أنا عاوز أعرف في أيه وأنتم مين ونحن مين، وكل أيه؟ ثم قال بمزيد من الاستغراب: أنا تعبان عاوز أعرف في أيه.
للأسف هذا هو الواقع العربي المرير، الذي يتناسل وتتوالد مآسيه وكوارثه، وهذا هو المواطن العربي الممزق المتشظي، الذي أصبح لا يدرك ما يحدث حوله، ولا يدري فيمن يثق.
تختلط الرؤية وتتداخل، فتلك اللافتات والعناوين التي ترفع في الساحات والميادين، والتي تنادي بالرحيل وإسقاط الأنظمة تصيب بالحيرة والتعجب، نتساءل ما معنى الرحيل ومن يرحل، وأي الأنظمة التي يراد إسقاطها؟ هل النظام يسقط؟ الفوضى والخراب هي مقابل للنظام، لكن هل كانت تلك أنظمة حقيقية؟ أم هي شيء آخر؟ على المستوى الجمعي لا أحد ينكر بأن جل الشعوب العربية تعيش تحت وطأة أنظمة قمعية، مسلوبة الحرية، تعاني الفقر والظلم والاستبداد والتضييق على الحريات والقمع، بمجرد ما تلقيه تلك الأنظمة من فتات ولقمة للعيش والأمن والأمان، تتعود الشعوب على تلك الحياة، ويتلبسها الخوف من مجرد التفكير في تغيير الوضع القائم، وتأييد الأصوات التي تنادي بذلك التغيير، والأدهى من ذلك يتحول ذلك إلى أسلوب حياة، وقد تتجلى تلك الصورة عندما تتحول الشعوب إلى الدفاع بشراسة عن تلك الأنظمة، بل وتتغنى بمحاسنها وبطولاتها وحكمتها، ويتطور ذلك إلى تعاطف الضحية مع جلادها المعتدي عليها، لدرجة التضحية من أجله، في صورة مشابهة لمرض «متلازمة ستوكهولم».. شيء لا يستوعبه العقل. وقد تتعدد أشكال تعاطف الضحية من الشعوب مع جلاديها الأنظمة، فتراها تنزل الميادين مؤيدة لعودة الدولة البوليسية، ورفع لافتات التأييد والانحناء، وتحويل رموزها إلى مصاف التقديس، والمباركة، وتكملة جميل تلك الأنظمة في مواصلة قمعها وتسلطها، والوقوف معها في وجه كل من يحاول الانتقاد والمس بها.
هل كتب للعرب بأنهم لن ينعموا أبداً بالحرية والديمقراطية، وأن مقولة الشعوب ليست جاهزة للديمقراطية بعد؟ هذا البَعد الذي لا يأتي ولن يأتي. تكالب على الأمة العربية أعداء الداخل والخارج، وكل من يتجرأ منهم أو يفكر بالحرية ومقارعة الظلم والاستبداد، سوف تكون نهايته مزيداً من الكوارث والتمزق وعدم الاستقرار. هل العرب لا يحسنون ثوراتهم، ولا هم يعرفون من يختارون من ممثليهم، وهل أصبحت الديمقراطية وبالاً عليهم.
يصف بعض المحللين تونس بأنها رجل الربيع العربي الأخير، الذي ظل على مرّ سنوات طويلة، يقف صامداً يدافع بكل قوة وبسالة ويصد أعتى الرياح التي تهب عليه بين الحين والآخر. تونس التي ألهمت العرب ربيعهم، وأعادت لهم كرامتهم في الثورة على الظلم والفساد في عام 2011، ورغم أنها لم تستقر منذ أن أطاحت بالنظام السابق، وما فتئت تنتقل من أزمة إلى أخرى، وتوالت عليها الأزمات، وتعثرت خطواتها كثيراً، لكنها لم تسقط وظلت متماسكة، وتتمكن من النجاة ومواصلة الإبحار، على أمل الوصول إلى شاطئ الأمان، ذلك ما كانت تعانيه على مدار السنوات الأخيرة. تونس ببساطة حالها حال غيرها من الدول التي لم تترك لحالها، ولم يرق لهم نجاحها النسبي في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان لا بد من معاقبتها والنيل منها، وظل المتربصون بها يبحثون عن الفرص لتحقيق أهدافهم. تأخر قطافها بعض الوقت، لربما شفع لها بأنها كانت أول دولة عربية انطلقت فيها شرارة الربيع العربي، واستطاعت أن تهدم جدرانا عالية وصلبة من الظلم والفساد والديكتاتورية. هل أعيى الوقوف ذلك الرجل وآثر الترجل كما فعل أقرانه في بعض الدول العربية، وترجّل وغادر المشهد وتوارى عن الأنظار. الحقيقة البائنة للعيان أن ذلك الرجل خانته الظروف وأتته الضربة من حيث لا يدري وطاحت به. وقطار الربيع العربي الذي انطلق من تونس محملاً ببشائر الحرية والانعتاق والديمقراطية مسرعاً نحو العديد من الدول العربية، وكانت تونس محطته الأولى، ها هو يعود بعد سنوات في هجمة ارتدادية، مثخناً بالجروح والألم، لتلحق تونس بركب تلك الدول التي ارتدت على أعقابها.
ما حصل في تونس ليس ببعيد عن ذلك، وبالتأكيد أن يوم الأحد 25 يوليو/تموز 2021 الذي أعلن فيه الرئيس التونسي المنتخب 73٪ بشكل ديمقراطي عام 2019 عن إجراءات استثنائية، مستنداً في ذلك على الفصل (80) من الدستور التونسي لسنة 2014 دستور الثورة. وكانت تلك الإجراءات إنهاء مهام رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا تولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء يعينه هو، وتولي النيابة العامة.
طريق الديمقراطية والحرية لم يكن أبداً طريقا سهلا ومعبداً ومفروشاً بالورود، وأعتى الديمقراطيات في العالم مرّت بتجارب ومنعطفات أكبر من ذلك، وكانت تأتيها الطعنات من الداخل أكثر، لكنها صمدت. استطاعت الثورة التونسية أن تنجز بعض الأهداف، وتسجل بعض النقاط المضيئة في مسارها، كالدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية، وارتفاع منسوب الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن تجربة الانتقال إلى الديمقراطية وترسيخ مؤسساتها، لا بد أن يمرّ بعثرات وثغرات، وقد ساعدت بعض الظروف في تراجع تلك التجربة، أول تلك العوامل الأزمة الاقتصادية، وظروف جائحة كورونا، وما تخلفه يوميا من كوارث، كل ذلك ترافق مع ظروف دولية وإقليمية، لا تستسيغ التحول نحو الأفضل، بالإضافة طبعاً إلى تغلغل الدولة العميقة في مفاصل الدولة، والفساد الذي ينخر تلك المفاصل، وعدم وجود النية في محاربته. كل ذلك بالطبع أيضا تصاعد حدة الخلافات بين السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة، وكذلك الخلافات داخل البرلمان بين مختلف التيارات، الذي تحول إلى مناطحات ومناكفات بين الأعضاء، كما تلك الحركات التي تختلقها إحدى النائبات، التي لا تليق أبدا بمجلس نواب للشعب، ما أثر في مسيرة النمو والتطور، عطّل الكثير من الخطط والبرامج، وكان له بالغ التأثير في الوطن والمواطن.
هل هو انقلاب كامل الأركان، أو هو انقلاب دستوري قانوني، وحق دستوري يخول الرئيس ذلك؟
في قراءة متأنية للفصل (80) من الدستور، الذي استند إليه الرئيس قيس سعيد في اتخاذ تلك الاجراءات، حيث تشير المادة إلى أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز له تقديم لائحة لوم ضد الحكومة…؟
من خلال ذلك هل يوصف ذلك بأن الرئيس استخدم الفصل (80) في رد الخطر الذي يداهم الوطن ويهدد كيانها؟ الرئيس أعلن بأنه اتصل أو أعلم رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة، وطبعا الاتصال أو الإعلام غير التشاور المنصوص عليه في الفصل، كذلك لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب، وهو اقترب من ذلك بأن جمده وعطله وأوعز للأمن بإغلاق أبوابه، على الرغم من أن الفصل 77 يتكلم عن الإجراءات الدستورية الخاصة بحل البرلمان. التدابير الاستثنائية التي يشير إليها الفصل، رغم أنه لا يوضحها، تبقى مشتركة بين السلطات الثلاث، الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، وتأتي من خلال مشاورات يجريها الرئيس، ربما ذلك لم يحدث بشكل وأضح. بلا شك أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد يمثل إجهاضا لتجربة الديمقراطية الوليدة، التي لم يكتمل نموها، وكان الأجدر به أن يحتضن تلك التجربة ويتبناها، كيف لا وهو الأستاذ في القانون الدستوري، وكان الأولى أن يكون هو الأمين عليها وحارس قيمها. مهما تكاثرت العلات والأمراض عليها. ها هو رئيس شرعي ومنتخب وأتت به الصناديق وبرافعة عالية قوية من ثورة الياسمين، هل هو الذي انقلب على نفسه؟ أم سلك طريقاً لابد منه لإنقاذ الوطن؟
لكن التاريخ لن يسجل بأن الرئيس وحده من يتحمل ذلك، كلهم من ليبراليين وإسلاميين ومستقلين. لغة التخوين والتصفيات لن تجدي نفعاً في إخراج تونس من أزمتها، ما لم يسد منطق العقل والبحث عن حلول مشتركة تجمع كل الأطراف، وعلى الجميع أن ينزل من الشجرة، والتنازل عن الكثير لصالح الوطن والمواطن. إلى أن تتضح الصورة وينجلي غبارها، لا أحد يتمنى أن تعود تونس إلى درجة الصفر، نتمنى أن يكون ذلك عثرة بسيطة وكبوة كان لا بد منها لتصحيح الكثير، وإعادة القطار إلى مساره مرة أخرى لينطلق من جديد إلى عوالم الحرية والانعتاق.
أعتقد لا يزال ذلك العربي تائها في الميادين والزقاق يبحث عن الإجابة لسؤاله (هو فيه ايه) بدون أن يجيبه أحد.
كاتب من عُمان
القدس العربي
—————————
ذا أتلانتيك: تونس والديمقراطية وعودة النفاق الأمريكي/ رائد صالحة
واشنطن- “القدس العربي”: تؤدي الانتخابات في بعض الأحيان إلى نتائج غير ملهمة، خاصة عندما تشكل مجموعة من الأحزاب حكومة ائتلافية غير عملية تكافح من أجل إنجاز الكثير من أي شيء، وهذا لا يعني أنه يجب الإطاحة بها، كما لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تتجاهل محاولات الانقلاب التي نُظمت بحجة تجاوز فوضى الديمقراطية، ولكن في تونس، يبدو أن هذا ما تفعله إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتكشف مجدداً عن اتساع الهوة بين الأقوال والأفعال الأمريكية، وفقاً لاستنتاج الكاتب شادي حميد في مقال ظهر أولاً في مجلة “ذا أتلانتيك” قبل أن تعيد نشره عدة مطبوعات أمريكية ودولية.
وأشار حميد من مركز سياسة الشرق الأوسط إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي من المفترض أن يتقاسم السلطة مع البرلمان ورئيس الوزراء بتعليق الأول وعزل الأخير، ولكي لا يشك أي أحد بنواياه، خاطب سعيد الأمة وهو محاط بالعديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وقال إنه ربما لا يهتم الغالبية من الأمريكيين بأن تكون تونس قصة النجاح الوحيدة في الربيع العربي ولكن أجواء القصة قد يكون لها صدى.
وكما يضيف الكاتب، فإن الولايات المتحدة نفسها شهدت حالة لنموذج “الرئيس” الذي يتوق لإظهار القوة، ولكن الولايات المتحدة، كدولة ديمقراطية طويلة الأمد، لديها مؤسسات ارتقت إلى مستوى التحدى وقيدت “الغرائز الاستبدادية” للرئيس السابق دونالد ترامب، في حين أن الديمقراطيات الشابة الهشة لا تتمتع بهذا الحظ.
ومنذ بداية رئاسته، حدد بايدن الصراع بين الحكومات الديمقراطية والاستبدادية على أنه التحدي المركزي لكل من الحاضر والمستقبل، وقال في أول مؤتمر صحافي له كرئيس إنه من الواضح أن هناك معركة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية في القرن الحادي والعشرين، وقد كان خطابه النبيل مفاجئاً إلى حد ما، خاصة بالنسبة لرجل شكك في الانتفاضات العربية عام 2011، وقال في لحظة لا تنسى قبل أسبوعين من سقوط الرئيس المصري حسني مبارك وسط احتجاجات حاشدة إن ” مبارك حليف للولايات المتحدة ولن أشير إليه على أنه ديكتاتور”.
وبحسب ما ورد، فإن الإيمان بقوة وإمكانيات الديمقراطية سهل من الناحية النظرية، ولكن مشكلة الديمقراطية في الممارسة هي أنها ليست بالجودة، التي يأمل أنصارها أن تكون عليها، ويمكن قول نفس الشيء عن كيفية استجابة الولايات المتحدة لانتهاكات الديمقراطية في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الحكم على طريقة الاستجابة بأنها ظاهرياً إلى جانب الحكم الشعبي، إلا أن البيت الأبيض رفض حتى الانحياز إلى أي طرف في تونس، وبدلا من ذلك، أعرب عن “قلقه” بشأن التطورات هناك، وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين بساكي “إننا لن نتخذ قراراً حول ما إذا كنا سنسمي ما حدث إنقلاباً”.
وتعد الأزمة التونسية أول اختبار حقيقي لالتزام بايدن المعلن بعقيدة الديمقراطية الجديدة، بعد أن أصبح تجاهل دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج أمراً مألوفاً في رئاسة ترامب غير العادية، وفي الواقع، كما يضيف الكاتب، قدم ترامب تجربة طبيعية، حيث تم إغلاق الفجوة بين الأفعال والأقوال لأول مرة بشكل كبير، وأصبحت الولايات المتحدة في عهده أقل نفاقاً.
ولم يعد على المعارضين التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستساعدهم، تحت أوهام حول الاهتمام الأمريكي بمحنتهم، ويمكنهم تكييف نشاطهم وفقاً لذلك والتركيز حصراً على سياقهم المحلي، وببساطة، كان ترامب غير قادر على خيانتهم.
وتحت قيادة بايدن، تتحدث أمريكا عن القيم والأخلاق مرة أخرى، في الداخل وفي الدول الأخرى، لا سيما الدول الضعيفة، وعلى حد تعبير الكاتب، القوة الأمريكية تسمح لها بامتلاك المُثل والقيم، ولكن ايضاً القدرة على تجاهلها.
ويتساءل حميد عن سبب عدم قيام الولايات المتحدة على إحباط انقلاب بطيء الحركة في تونس؟ وهي دولة نائية نسبياً ومخاطر التدخل قليلة للغاية، على النقيض من مصر، كما طرح الكاتب علامة استفهام عن المدى الذي يمكن للولايات المتحدة فيه أن تؤثر فعلياً على الشؤون الداخلية للدول البعيدة؟ وهل هناك أي شيء يمكن أن تفعله إدارة بايدن؟ والإجابة القصيرة هي نعم، حيث يمكن لإدارة بايدن أن تهدد بتعليق كامل للمساعدات إذا لم يبدأ الرئيس التونسي بعكس المسار.
والمشكلة في عدم الرد الأمريكي، كما يضيف الكاتب، هي أن عدم التدخل سيبعث برسالة إلى القادة المستبدين مفادها أن المسؤولين الأمريكيين لا يرغبون في متابعة التزاماتهم المعلنة.
وبالنسبة للمخاوف من مخاطر التهديد، قال الكاتب إن تونس بحاجة للولايات المتحدة أكثر مما تحتاجه أمريكا من البلاد، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع أوروبا قبل اتخاذ أي خطوة.
القدس العربي
—————————-
شطب فصل الربيع من التقويم العربي/ حلمي الأسمر
مهما قيل عما حدث، أخيراً، في تونس من “تأويل” وتزيين وإعادة إنتاج، فهو انقلابٌ فظ، حتى وإن لم ترافقه إراقة قطرة دم واحدة، وإن كان عنوانه الأساس عملية ذبح للدستور باسم الدستور.
أكثر ما يغيظنا – نحن الكتّاب في المشهد – حين يخرج عليك تونسي أو تونسية ليصرخ في وجهك قائلاً: أنت مالك ومال تونس، نحن أدرى بشعاب “مكتنا”. وهنا تحديداً يصدمك هذا الشعور الفظّ والغبي في آن. أولاً، لأنّك تشعر أنّ فيروس سايكس – بيكو قد عشّش في النخاع الشوكي لبعض العرب، وهم يعرفون، إن أرادوا، أنّ البلاد العربية جسد واحد، جرى “نشر” أجزائه وتقطيعه إرباً إرباً بقصد وتخطيط، كي يبقى خارج دائرة الفعل. وثانياً، هؤلاء يهرفون بما يعرفون أو لا يعرفون، أنّ ما يجري في تونس أو مصر أو حتى في جنوب السودان يؤثّر على أقصى قرية في بلاد الشام. وبمعنى أو آخر، يصبح انقلاب تونس حدثاً محلياً في عمّان وبغداد ونواكشوط. ولعلّ هذا ما يدركه جيداً أولئك القوم الذين جنّدوا كلّ مواردهم وشياطينهم لشطب فصل الربيع من التقويم العربي، باعتباره نذير شؤم على الدكتاتور العربي، فهو يخشى من عدوى الزهور التي تفتّحت في بعض البقاع العربية، ويريد أن تبقى “صحراء العرب” على حالها القاحل البلقع، بلا جداول ولا طيور حرّة، ولا طقس تتنفس فيه الكائنات نسائم الحرية.
القصة ليست متعلقة بالإخوان المسلمين، وما فرّخت، بوصفها مدرسة دعوية وسياسية وإحيائية، من أحزاب وحركات واتجاهات، حملت مشعل التغيير. الهدف هنا سحق الوعي، حتى ولو كان يحمل راية العلمانية والكفر البواح. الهدف محاصرة أيّ مشروع للنهضة والقيام من الحفرة السحيقة التي انزلقت إليها الأمة، وديمومة حالة السيولة، والاستقالة من سجل الحضارة الإنسانية، وصولاً إلى بقاء هذا أو ذاك جالساً على كرسي الحكم.
ولعلّ من سوء طالع الأمة أو حُسنه، لا أدري، أنّ من تصدّر حكاية الربيع الراية الإسلامية، ربما لأنّها التعبير الأكثر صدقاً عن وجدان الأمة وعقيدتها، وربما لأنّها الأكثر تنظيماً في بلاد العرب، ولهذا أصبحت هذه الراية الأكثر استهدافاً وشيطنة.
تماهي النخبة العربية المحاربة للربيع مع كيان العدو الصهيوني كان لافتاً بامتياز، منذ اللحظات الأولى لإزهار الربيع، حين تشكّلت، على الفور، جبهة عربية صهيونية للإجهاز على الربيع، أثمرت في ما بعد منظومة اتفاقات تطبيعية، ظاهرها اتفاقات سلام وباطنها حلفٌ لشطب الربيع من التقويم العربي. وكي لا يرفع أحد القراء حاجبه مستغرباً، أعود إلى سنوات قريبة، في ذروة هبوب نسائم الربيع، في عام 2012، حين أصبح ما كان يجري في ميدان التحرير في قلب القاهرة، وبقية ميادين التحرير العربية، كابوساً يمنع العدو الصهيوني من النوم… بل حزم هذا الكيان أمتعته وبدأ، حينذاك، يستعد للحرب، بعد طول اطمئنانٍ للسبات العميق التي كانت تغطّ فيه أمة العرب، وخطوط تماسّها مع الكيان!
للمرّة الأولى منذ أعوام بعيدة، أدخل جيش الاحتلال آنذاك فرضية عبور نهر الأردن إلى الجهة الشرقية منه ضمن أهدافه استعداداً للسيناريوهات المقبلة، الأكثر سوءاً بالنسبة له، إذ بدأ الجيش الصهيوني حينها بالتدريب على محاكاة سيناريو مواجهات مع الأردن، الجبهة التي يعتبرها العدو الأكثر هدوءاً واطمئناناً، واستخدام مختلف المعدّات الحربية، وبينها صواريخ مضادّة للدبابات. وبحسب الأخبار التي بثت حينذاك، فإنّ “التدريبات في نهر الأردن جرت في ساعات الليل أيضاً، إذ أعدّ الجيش كمية من الجسور لاستخدامها عند عبور النهر، بعضها بطول عشرات الأمتار، كما تم التدريب على قوارب مطاطية وحبال وعبور مدرعات”. كان التدريب على اجتياز “الشريعة” جزءاً من تدريب كبير، ترافق مع مناورةٍ للجبهة الداخلية الكبرى في تاريخها والمسماة “نقطة تحوّل 5” في سياق ما سمّاه جيش الاحتلال تدريبات “الحرب المتدحرجة” التي وُصفت بأنّها الأوسع لناحية الفترة التي استغرقتها ومتطلباتها الخاصة، وهم، وفق تصريحاتهم، كانوا لا يستبعدون، في السياق، سيطرة مصادر معادية على مخازن السلاح الكيميائي في سورية، وبدأوا يعزّزون الجهوزية لسيناريو يتضمن استخدام سلاح غير تقليدي، وسقوط صواريخ على كيانهم. ولهذا شملت التدريبات تأهيل 86 مجموعة مراقبة في خدمة الاحتياط، كان سيتم نشرها في أثناء الحرب “المفترضة” في أرجاء البلاد لتبلغ عن الأماكن الدقيقة لسقوط الصواريخ. وعلى وقع هذه التدريبات أطلق الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الحرب آنذاك، تحذيراً من أنّ سقوط نظام بشار الأسد سيترتب عليه حدوث كارثة تقضي على تل أبيب، نتيجة ظهور إمبراطورية إسلامية في منطقة الشرق الأوسط بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسورية. ووفق إذاعة جيش العدو في حينه، قال جلعاد إنّ الفكر المعلن الذي تنتهجه الجماعة في البلدان الثلاثة يهدف إلى تصفية دولة الكيان الصهيوني ومحوها، وإقامة إمبراطورية إسلامية تسيطر على منطقة الشرق الأوسط. وقال الجنرال جلعاد حينها إنّ “إسرائيل” شعرت بالأخطار التي تواجهها من عدة جهات، خصوصاً مصر. ولهذا قرّرت أن تحسّن علاقاتها مع تركيا، وتتحاشى القطيعة الدبلوماسية معها، حتى لا تضطر تل أبيب إلى محاربة المسلمين في عدة جبهات مفتوحة، ستؤدّي، في النهاية، إلى خسارتها بالتأكيد!
حينما نعود إلى تلك الأيام، والربيع في ذروته، والزلزال الذي أحدثه في كيان العدو، ندرك اليوم مدى أهمية قبر الربيع حيث ولد، في تونس تحديداً، وأيّ قراءةٍ لما يحدث في تونس خارج هذا السياق تغميس خارج الصحن، ومحاولة للتضليل.
قد يكون للإسلاميين استبدادهم، وفق أصحاب نظرية “شيطنتهم”، لكنّه الاستبداد الوحيد القادر على تفكيك ليس الكيان الصهيوني فحسب، بل منظومة الاستبداد الذي ربض على صدور الناس عقوداً طويلة، وكان خير “صديق” لعدونا، وحارساً أميناً لمصالحه وأمنه.
إذاً، هي محاولة ليس لشطب فصل الربيع من التقويم العربي فحسب، بل توفير ربيع دائم أيضاً لكيان الاحتلال المتوحش الذي ما فتئ يعيث فساداً وتخريباً، ليس في فلسطين فقط، بل في مجمل الجغرافيا العربية والإسلامية، والعالمية أيضاً، بما ينشره من موت ودمار ومرتزقة وتكنولوجيا سوداء للتجسّس والخراب.
العربي الجديد
—————————–
من يحمي الديمقراطية في تونس؟/ سمير حمدي
مهما اختلف توصيف ما جرى في تونس يوم 25 الشهر الماضي (يوليو/ تموز) بين ما يقول عنه المؤيدون إنه تصحيح مسار، وتأكيد المعارضين له أنه محاولة انقلاب على المسار الديمقراطي برمّته، فالأكيد أن الوضع الحالي يشوبه الغموض والترقب، في ظل عدم وضوح الخطوات التالية التي يعتزم القيام بها رئيس الجمهورية، باعتباره المستأثر حاليا بكل الصلاحيات، ويجمع بين يديه كل السلطات.
ربما كان ما حصل نتاجا لحالة الانغلاق السياسي التي شهدتها البلاد منذ انتخابات 2019، وحالة العجز عن تصريف الأزمات المتراكمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات بالغة السوء للجائحة الوبائية، وهو ما دفع قسما من الشعب إلى حالة من التململ وتأييد تجميد الحياة السياسية وإيقاف السير الاعتيادي لمؤسسات الدولة. غير أن هذا وحده لا يكفي لتفسير الحدث في ذاته، فقد كان واضحا وجود حالة من عدم الثقة بين مراكز السلطة في البلاد، وهو ما أفضى إلى تهديد النظام الديمقراطي واحتمال العودة إلى السلطوية.
ربما كان من نقائص الديمقراطية التونسية غياب ديمقراطيين فعليين يدفعون إلى تعزيزها، وإرساء مؤسساتها التي يمكنها أن تستمر من خلالها. ويتجلى هذا في جانبين: أولهما الإطار الإجرائي المؤسسي، ونعني به تحديدا استكمال بناء المؤسسات الضرورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وقد مرّت السنوات الخمس ما بين 2014 و2019 في مناكفاتٍ سياسيةٍ، وفي صراعات الكتل الحزبية، من دون إصرار جدّي على استكمال هذه الخطوة التي اكتشف الجميع لاحقا أهميتها، بوصفها ضلعا مركزيا لاستمرار أي نظام ديمقراطي. والجانب الثاني هو أداء النظام الديمقراطي ومخرجاته، لأنه إذا كان هدف الديمقراطية صون حقوق الإنسان وحريته وكرامته وتحقيق المساواة في فرص الحياة بين الجميع، فإن هذا الأمر لا يتحقق فقط بإقامة المؤسسات والإجراءات، ولكن أيضا من خلال أداء السلطة وجهدها في تحقيق الأدنى من حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا مؤدّاه أن الديمقراطية، وإن كانت تقتضي جانبا إجرائيا مؤسسيا يتعلق بتكوين الأحزاب وتنظيم الانتخابات والفصل بين السلطات، فإن تعزيز أركان الديمقراطية تركز على الجانب الاجتماعي، المرتبط بالتأثير الإيجابي للنظام الديمقراطي على حياة الأفراد.
وإذا كان من غير الممكن انتظار معجزة اقتصادية من نظام ناشئ، وريث سنوات طويلة من الإخفاق، فإنه لا يمكن إنكار أنه طوال السنوات العشر لم يكن هناك عمل جدّي لتعزيز الديمقراطية وحمايتها من مخاطر الرّدة عليها. بل على النقيض من ذلك، نلاحظ حالة من الأداء الكارثي لأحزاب البرلمان التونسي، والتي تصرّف بعضها عن سوء نيةٍ، فيما تصرّف آخرون انطلاقا من المصلحة الذاتية المفرطة. وهنا يمكن الإشارة إلى السلوك الممنهج الذي اعتمدته عبير موسي، من الحزب الدستوري الحر، بين أروقة البرلمان، في أساليب إثارة الفوضى والتهريج، بشكل أثار نقمة الجمهور الذي يتابع الأحداث. وإذا أضفنا هذا الميل المعلن لدى نواب حركة الشعب إلى إلغاء المسار الديمقراطي، وهو ما انكشف من خلال تأييدها المطلق الإجراءات الرئاسية أخيرا، ندرك حجم الضغوط التي كانت مسلّطة على المسار الديمقراطي التونسي. في المقابل، تصرّفت قوى سياسية أخرى بنوع من البحث عن المصلحة الحزبية المفرطة أكثر من الرغبة في ترسيخ المسار. فحينما كانت التعبئة على أشدّها ضد البرلمان والعملية السياسية برمتها، خرج رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، ليتحدّث عن تعويضات ضحايا الاستبداد السابقين، وكأنه يحمل البنزين لإشعال الحريق. وفي وضع متردٍّ وبرلمان عاجز وتحريض إعلامي وقوى إقليمية منزعجة من استمرار النموذج التونسي، كان من السهل استغلال أي تصريحاتٍ من هذا القبيل، لمزيد التحشيد أو على الأقل التعبئة النفسية ضد الديمقراطية، على الرغم من أن التفكير المنطقي يقول إن الديمقراطية ليست مسؤولة عن سلوك الأحزاب أو التنظيمات، بقدر ما هي آلية لتنظيم الحياة السياسية وتجنب الانزلاق نحو الحكم السلطوي أو الفوضى المجتمعية.
المشكلة الحالية التي تواجهها تونس لا تكمن فحسب في استمرار تعطل المؤسسات، وإنما أيضا في غياب تصور واضح للأيام المقبلة، فلا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه. وفي الوقت نفسه، ينبغي مراجعة قواعد الممارسة السياسية، فلم يكن ضروريا تعطيل أجهزة الدولة وتجميد البرلمان لحل الأزمة، فقد كان من الممكن السير نحو حوار وطني واسع وشامل، تتم فيه مناقشة كل المشكلات من أجل الوصول إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها السليم. ويدرك الجميع أن لا أحد يملك حلولا جاهزة للخروج من الأزمة، وأن تجميع السلطات بيدي رئيس الجمهورية لا يعني قدرته على حل المشكلات بعصا سحرية، كما يعتقد مؤيدوه، وإنما قد يكون مدخلا إلى نظام سلطوي مجهول العواقب.
العربي الجديد
————————
روشتة عبيّد لإنقاذ قيس بن سعيّد/ عبد الحكيم حيدر
1 – بعد الكشف الطبي على هشام المشيشي، يجب، على وجه السرعة، توفير عقد عمل له في الإمارات، براتب ضعف راتبه في تونس، مكافأة له على تصريحاته الإيجابية في حق الانقلاب، سواء أكانت برضاه أم تحت تأثير السلاح. وليكن سكنه بالإمارات على مقربة من سكن عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق.
2 – على وجه السرعة أيضا، تجب إقامة مباراة في كرة القدم ما بين فريقي النادي الأهلي المصري وصفاقس، على أرض تونس الخضراء بالطبع، إمعانا في مكايدة الخصوم. وأن تتقدّم الجماهير التونسية السيدة عبير موسي، بلباس عسكري بالطبع، وتستقبلها في المدرّجات السيدة المصرية فيفي عبده، بزغرودة طويلة جدا، تصفق لها الجماهير طويلا. ولا مانع أيضا من أن تسلط الكاميرات على قيس بن سعيّد، وهو يضحك أيضا للزغرودة. أما بقية الحفل ومقدّمته يسرا من المدرجات، قبل انطلاق المباراة، فسوف يكون تنافسا في جمال الفساتين ما بين فستاني ليلي علوي ويسرا، وتبزّهما بالطبع فساتين بنات تونس الخضراء، مع مراعاة أن تنتهي المباراة في كرة القدم بين الفريقين بالنتيجة “هدف وحيد لهدف وحيد”، مع استمرار الحفل على أرض المباراة للساعات الأخيرة من الليل.
3 – حذار من أن يندسّ مرتضى منصور في الوفد المصري، فقد تكون النتيجة عكسية ومنيلة بطين وقطران.
4 – حاول بكل الطرق أن توجّه دعوة لحضور الحفل إلى المبشر بثورة تصحيحك قبلها بأيام، وهو المفكر الحر المستقل جدا، ضاحي خلفان. ولا أضمن لك النتائج في المدرجات أيضا، فقد تكون “أطين” من نتائج حضور مرتضي منصور مندسّا.
5 – حاول في أضيق الحدود عمل خمسة أو ستة مؤتمرات للشباب مع مراعاة التقشّف نظرا إلى ضيق ذات اليد، مع شرح ذلك للإخوة العرب، ولتكن المؤتمرات على البحر، وفضفض باللغة العامية، ودعك من القواميس. ولا تنس أن تكون عاطفيا، وتقبل لك طفلين من أطفال شهداء الإرهاب، وتمنحهما “عيدية” نجاح الانقلاب.
6 – عزّز في خطابك الإعلامي القادم من خطاب المودّة مع كل الأخوة العرب. وضع أمر قواتك المسلحة تحت إمرة أي بلد عربي يحتاجه لمواجهة أي عدو. وركز على كلمة “أي عدو” تلك، وكرّرها مرات ثلاثا، على غرار “تحيا مصر”، ثلاث مرّات. وقل أيضا كلمة من بهارات النجدة والنخوة من العربي للعربي على غرار “مسافة السكّة”، سواء أقلتها من القاموس أم من الدارجة التونسية. المهم أن تكون حازما وحاسما في الإلقاء.
7 – تصوير مسلسل على وجه السرعة عن ذلك المخطط الإرهابي الذي كان يخطّط له راشد الغنوشي وحزبه في الخفاء، ولولا ستر الله لضاعت تونس.
8 – أنصحك بالاستعانة بالخبرة المصرية، وخصوصا في الاستراتيجية العسكرية، وخصوصا اللواء حمدي بخيت. أما من ناحية الخبرات الطبية التي كان من الممكن أن تحل كل مشكلات تونس الصحية، بعد هذه الأعداد المصابة بالفيروس، فأظنك غير محظوظ بها بالمرّة، فقد انتقل اللواء عبد العاطي إلى جوار ربه، إلا أن هناك أملاً يتبقى لك، أن يكون قد ترك لدى الورثة بعض الأبحاث في معامله ومختبراته ما يساعد العلماء في تونس على تكملة مشواره، والاستفادة من تلك الأبحاث، وهذا بالطبع ممتازٌ لك وللعلم.
9 – امنع كل رجال أعمالك من السفر، وحدّد إقاماتهم وأسرهم، حتى يُخرجوا ما تحت البلاطة، وأنصحك أن يكون لك “صندوق على جنب كده”، سمّه “صندوق المحن”، ولا يصرف أي شيء منه، إلا بأمرك. وإذا أردت “فاصلا من الهزار الطيب”، دع سيداتٍ فقيراتٍ يتبرّعن للصندوق بخلاخيلهن وصناديق زواجهن، ولا تنس أن تأمر لإحداهن “بحجة”.
10 – قاسم أصحاب المحاجر والمقالع في محاجرهم ومقالعهم، وحتى أصحاب مراكب الصيد، فخذ ممن معه “رفّاصين” رفاصا، واتركه يعمل بسلام.
11 – وصل أي جزيرة تونسية بالبحر بجزيرة أخرى قريبة جدا، بكوبري، وسم الكوبري باسم ثورتك.
12 – دع بعض أملاك الجاليات اليهودية لأصحابها، على أن ينشروا هذه الأخبار في الجرائد العالمية.
خاتمة: هذه روشتة فيها ما يحتمل الصواب، وفيها ما يحتمل الخطأ. المهم نجاح التطبيق، وقديما قالوا: “اسأل مجرّب ولا تسأل طبيبا”، ولكن عم زين السمكري قال أيضا: “إن حسن مش زي حسنين”، والله أعلم.
العربي الجديد
————————-
تونس، “لحظة قيصرية” دون قيصر/ تيري بريزيون
ترجم المقال من الفرنسية مسعود الرمضاني.
شبح ينتاب تونس، وهو شبح “القيصرية”، وفرضية بروز قائد قوي يكون محبوبا أو مُهابا ليعيد ترتيب دولة أنهكتها الفوضى، تتخلل باستمرار الحوارات السياسية في تونس. منذ سقوط زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وجد الكثيرون في تونس أنفسهم يتامى، مفتقدين صورة الأب الوصي والحازم والمتبصّر، أو بعبارة أخرى، يفتقدون “الزعيم” على طريقة الحبيب بورقيبة، الذي كان بن علي صورة مشوّهة بعض الشيء منه. لكن منذ بضعة شهور، تتضاعف عناصر أزمة متعددة الأبعاد وتتجمع مكوناتها الدرامية لتستدعي بأكثر إلحاح سيناريو قيصر جديد في الحكم.
عقبة الديون
غمرت الموجة الرابعة لجائحة كورونا قطاعا صحيا مستنزفا، مما يشي بأن الصائفة ستكون أكثر فتكا. وقد كشفت الجائحة جليا قصر نظر الدولة وعجزها على إنفاذ قرارات استعجالية في مجتمع ممزق وبخدمات عامة متداعية.
تتلقى تونس ارتدادات هذه الصدمة في ذات الوقت الذي تواجه فيه عقبة مديونية حادّة بعد عشر سنوات من التدهور المالي. فقد تطوّر حجم الدين من 45 بالمائة من الناتج القومي العام سنة 2010 إلى حوالي 100 بالمائة الآن. هذا وتفاوض البلاد بشأن قرض رابع من صندوق النقد الدولي، ويبدو اقتصادها عالقا في دوامة أزمة قاتلة في غياب إصلاحات ليبرالية أو نموذج اقتصادي بديل، إذ لا يُرى سوى احتضار بطيء لمرحلة لم بعد تُحتمل. إذ لم يعد بإمكان الدولة شراء السلم الاجتماعية، كما بدأ “الريع الديمقراطي” يُستنفد لدى الشركاء الأجانب، إضافة إلى أن الترقيم السيادي لتونس قد انخفض ثماني مرات بعد عشر سنوات لتصنفّه وكالة “موديز” في فبراير/شباط الماضي تحت علامة “بي3” مع نظرة مستقبلية سلبية، وكذا بالنسبة إلى وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي وضعت تونس في المرحلة الأخيرة قبل التخلف عن سداد الدين في 8 يوليو/تموز الجاري.
هذا إضافة إلى أن تونس ملزمة خلال هذه الصائفة بسداد قسطين من دين يُقدّر كلّ منهما بـ500 مليون دولار، وهي تحاول إذن الحصول على مبلغ 12 مليار دينار (4.26 مليار دولار) لسداد الدين الملزم وخلاص الأجور خلال الأشهر الثلاثة القادمة. قد تستطيع هذه المرّة الإفلات من العجز عن سداد الدين ومن فرضية المرور أمام نادي باريس لإعادة جدولة ديونها، ولكن ذلك سيكون على حساب مزيد التداين وتجفيف الموارد، والسؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟
حرب المواقع وازمة الهيمنة
لقد غذّت هذه الصدمة الصحية والمالية الصراع المفتوح بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة والأغلبية البرلمانية وأساسا حركة النهضة -اللّذان يرأسهما راشد الغنوشي- ومعه رئيس الحكومة من جهة أخرى، حيث حاول قيس سعيد جاهدا منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسط يده على رئاسة السلطة التنفيذية. لكن هشام المشيشي الذي عيّنه سعيّد نفسه خلفا لإلياس الفخفاخ في يوليو/تموز 2020، كان قد وجد الدعم والسند الكافيين من الأغلبية البرلمانية.
وقد انطلق الطرفان في حرب مواقع، فالهجوم الذي شنّه المشيشي في أواخر شهر يناير/كانون الثاني بتحوير وزاري من أجل توسيع صلاحياته (خاصة في وزارة الداخلية) أحبطه قيس سعيد، قائلا إنه بم يقع احترام الإجراءات الدستورية وإن الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد، لذلك رفض قبولهم لأداء القسم، وهو أمر ضروري لتنصيبهم. وكانت النتيجة أن الحكومة الأخيرة كانت تعدّ خمسة وزراء بالنيابة، منها وزارتي سيادة وهما الداخلية والعدل.
في المدة الأخيرة، رفض قيس سعيد إصدار تعديلات على القانون الأساسي المتعلّق بتشكيل المحكمة الدستورية والذي يسمح بخفض عدد الأغلبية الضرورية لتعيين أعضائها من قبل البرلمان، ذلك لأن رئيس الدولة يرتاب من استغلال الأحزاب السياسية لهذه الهيئة القضائية العليا، فضلا عن تجاوز التاريخ المقرر لتشكيل هذه الهيئة الدستورية بخمس سنوات.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، أقال رئيس الحكومة رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد عماد بوخريص، فاستقبله رئيس الدولة في اليوم الموالي، شاجبا إعفاء “أولئك الذين يحاربون الفساد” من مناصبهم.
هذا وتحصّن كلا الطرفين دون أن ينجز أي منهما اختراقا حاسما. ولم يتوصل أي منهما إلى اتفاق حول متطلبات الحوار (من سيكون حول الطاولة وجدول الأعمال). وفي الأثناء، تنهار مؤسسات الدولة أمام مرأى الجميع.
وفي الواقع، فإن الأزمة الحالية هي نتاج لانتخابات 2019، التي أسفرت عن أغلبية برلمانية مبتورة ورئيس دولة في قطيعة تامة مع الأحزاب. كما أنها أيضا تعبير عن رفض للطبقة السياسية ولمأزق “التوافق” الذي لم يأت بحلول. يجمع هكذا وضع كل مكونات ما يسميه المفكر الإيطالي انطونيو غرامشي “أزمة الهيمنة” أو “أزمة عضوية”: انهيار الاقتصاد، انقسام النخبة السياسية وتآكل شرعيتها حتى أنها باتت عاجزة عن المحافظة على الظروف السياسية التي تسمح باستمرار أجهزتها، انهيار المؤسسات، تكلّس الأحزاب السياسية “المفرغة من كل محتوى اجتماعي” و “المحلّقة بعيدا عن الواقع” وطبقات اجتماعية “تابعة” دون تمثيلية تنظيمية تخوّل وصولها إلى الحكم.
هيّأ هذا “التوازن الكارثي للسلطة” الظروف “للحظة القيصرية”. ويستدعي الوضع إعادة التأسيس عبر شخصية كاريزمية.
قيس سعيد يدفع باتجاه نظام حكم جديد
يعتبر رئيس الجمهورية نفسه مهيئا لهذا الدور، ويرى نفسه منذ انتخابه حصنا منيعا للدولة وللسيادة الشعبية لصدّ “أعداء” لم يحددهم حتى وقت قصير، ومفسدين يعملون سرّا ضد مصلحة الوطن، وقد كانت حركة النهضة من بين المعنيين ضمنيا بهذه الهجومات.
ويستغل سعيّد بعض الغموض الموجود في الدستور لدعم صلاحياته. فقد طالب أخيرا عبر قراءة مبالغ فيها للفصل 77 من الدستور الذي يحدد مهامه
1
بجعل قوات الأمن الداخلي تحت سلطته، على حساب رئيس الحكومة طبعا.
بالإضافة إلى أن مواقفه المتصلبة والانعزالية تثير الغموض والحيرة، وتدفع بالدوائر السياسية والدبلوماسية التي تعودت على مسؤولين يبحثون عن التحالفات والتوافقات، إلى سؤال دائم: “ما هو هدفه؟” ذلك أن تصريحاته المبهمة كانت تثير الغموض حول نواياه.
ثم قد يكون عبّر خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عن رغبته في العودة إلى صيغة معدلة من دستور 1959، دون تفصيل لطبيعة هذا التعديل، رُغم اعتباره في وقت سابق أن “تلك النسخة كانت صُممت على مقاس شخص وحزب”، ثم اعتبر أن “نواب المجلس الوطني التأسيسي (2014) اعتمدوا ذات النهج، لكنهم صمموا أكثر من بدلة لتظلّ على مقاس التوازنات التي أفرزتها انتخابات 2011”. وفي هذا الإطار، تكهن سعيّد منذ يناير/كانون الثاني 2014 بوقوع “تجاذبات خلال الانتخابات القادمة وذلك في ضوء تغيير التوازنات السياسية التي تحدث في غضون ذلك”. مضيفا أن “غياب الإرادة السياسية لمراجعة حقيقية للنظام من أجل مشروع بديل يقطع مع الماضي قد ظهر جليا”.
ولا يبدو أن قيس سعيد قد تخلّى عن المشروع الذي بنى حوله حملته الانتخابية، أي “قلب هرم السلطة” والتأسيس لتمثيل شعبي جديد يستوجب بناؤه تجاوز الأحزاب السياسية وإلغاء التمثيل النيابي الحالي، وهو مشروع ينطلق من التمثيل المحلي إلى الوطني من أجل تجسيد السيادة الشعبية. وقد كان أعلن عن ذلك عند اجتماعه برؤساء حكومات سابقين يوم 15 يونيو/حزيران حين قال: “إن مهمتي تتمثل أساسا في مواصلة الانفجار الثوري مع التقيّد الصارم بالمؤسسات”. وقد كان أكثر وضوحا خلال هذا اللقاء، حيث أشار إلى المآلات التي يريد إعطاءها إلى الأزمة: “أنا مستعدّ للحوار، لكن الحوار الحقيقي لا يجب أن يكون محاولة يائسة وبائسة لإضفاء مشروعية كاذبة للخونة واللصوص. (…) كما يجب أن يكون الفصل الأكثر أهمية للحوار حول مسألة النظام السياسي ونظام انتخابي جديد يصبح بمقتضاه كل نائب مسؤولا أمام ناخبيه. كما يجب أن يفضي الحوار إلى الانتقال من الوضع الحالي إلى وضع جديد، بعيدا عن كل صفقة مع الداخل أو الخارج”.
وبذلك يكون قيس سعيّد قد تباين بوضوح مع الحوار الوطني لسنة 2013 “التوافقي” الفوقي، للتوليف بين النخب القديمة الساعية لإعادة “الرسكلة” ونخب النهضة الصاعدة الباحثة عن الاندماج. ولئن ساهم ذلك الحوار في تهدئة الساحة السياسية، فإنه ضبط أيضا إيقاع الانتخابات التشريعية الأولى (2014-2019) التي عوقبت بانتخابات 2019 بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وفشلها في استيعاب الانتظارات الشعبية. وبعبارة أخرى، يسعى قيس سعيد إلى وضع حدّ لهذه الصيغة التوافقية للانتقال الديمقراطي. وبصفة أعم، يبرز إصراره على الحديث عن الفساد رغبته في قطع علاقة الدولة بدوائر الأعمال والتدخلات الأجنبية.
رئيس في عزلة
يراهن قيس سعيد لبلوغ أهدافه على ديناميكيتين: شرعيته الشعبية المباشرة واهتراء شرعية البرلمان، وهو يسعى بذلك لفرض نفسه في اللحظة الحاسمة كبديل أوحد لسلطة فاشلة، لكن “مسار التاريخ” قد لا يكون كافيا لتعبيد الطريق أمامه.
فالشركاء الأجانب الذين لهم نفور طبيعي من المغامرة السياسية يرتابون منه. أما النخب التونسية، فتعتبره متهورا، ذا نزعات معادية للحرية، وما من وسيلة إعلام أو حزب سياسي أو مثقف يدعم مشروعه، كما ليس هناك من شخص في موضع مهم من مفاصل الدولة يمكن أن يدفع في لحظة تسريع عجلة التاريخ باتجاه مشروعه.
في أواسط مايو/أيار، نشرت “ميدل ايست آي” وثيقة وصفتها بالمسربة من رئاسة الجمهورية تعرض تفاصيل خطة، لا بغاية “انقلاب عسكري” بالمعنى الدقيق للكلمة بما أنه لا يفترض عزل أية سلطة، ولكن بغاية تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يمنح لرئيس الدولة كل السلطات عند مواجهة “خطر داهم”، “يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة” وهو ما يُعتبر قفزة إلى المجهول بالنظر إلى أن المحكمة الدستورية التي يمكن اللجوء إليها خلال ثلاثين يوما للتأكد من مدى صحة “الظروف الاستثنائية” غير موجودة الآن.
ولا يوجد في الوثيقة غير الممضاة ما يسمح بتقييم وضعها: هل جاءت بمثابة نصيحة طلبها رئيس الدولة؟ وعلى أي مستوى وقعت مناقشتها؟ أما الرئيس، فقد أكد علمه بها ولكنه أشار أنها لا تلزمه.
وتبقى عملية التسريب هي الأهم، حيث لم تنتهز حركة النهضة الفرصة لإطلاق حملة دعائية علنية ضد قيس سعيّد والتذكير بحرصها على حل تفاوضي. لكن الحزب أعرب عن قلقه لدى السفارات الأجنبية حيث يُعتبر نشر مشروع انقلاب دستوري بذلك الوضوح تأكيدا للمخاوف التي تطفو على السطح منذ أشهر عديدة. وقد سحبت عملية النشر خاصة البساط من تحت أقدام قيس سعيد الذي أُجبر على التباين مع هذه الفرضية.
الجيش، استثمار آمن
دعما لرغبته في تجسيد الدولة ووحدتها، يسعى قيس سعيد للظهور باستمرار مع الجيش، باحثا دون شك عن السند للوقوف صدّا منيعا في مواجهة “سلطة الأحزاب” ولكن يظل الجيش على حياده وتبقى فرضية تدخل عسكري مباشر في الساحة السياسية غير محتملة، إذ خلافا للجزائر أو مصر، حيث إن بقاء النظام حيوي بالنسبة للجيش، يحبذ الجيش التونسي في زمن الأزمات الحادّة تحفيز السياسيين على العمل من أجل تثبيت استقرار المؤسسات. وعلى سبيل المثال، وجّه جنرالات متقاعدون، أواخر مايو الماضي، رسالة مفتوحة الى قيس سعيد يدعونه فيها الى تقديم تنازلات.
ولكن ما الذي سيحدث لو ظل الوضع بهذا الانسداد الخطير؟ أي المواقف ستسندها الكوادر العليا للجيش إذا ما قررت التدخل؟ هذا غير معلوم الآن.
في الأثناء، يظل الجيش رأس مال رمزي واستثمارا آمنا فعلا. وقد حاول مترشحون آخرون لدور القيصر استمالته لصالحهم. فخلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، أصرّ عبد الكريم الزبيدي، آخر وزير دفاع للباجي قائد السبسي، على عقد اجتماعه الانتخابي الأهم أمام الصور الضخمة لأبرز قيادات أركان الجيش العليا. ولكن هذه الرمزية لم تحقق له نجاحا ملموسا، حيث كان ترتيبه الرابع بنسبة 10.7 بالمائة من الأصوات.
حاليا لا يخفي الأميرال المتقاعد كمال العكروت، المستشار العسكري للباجي قائد السبسي، طموحاته السياسية. ويطرح نفسه بديلا احتياطيا ممكنا في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكنه اكتفى إلى حد الآن هو الآخر بمطالبة قيس سعيد باستعمال صلاحياته خاصة ضمن مجلس الأمن القومي من أجل إيجاد حلاّ للأزمة.
وعبر طريقة أكثر فلكلورية، لا تتردد عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، في الاستعراض بثياب تشبه تلك التي تستعمل في التمويه العسكري خلال تظاهرها في الشارع. وتستفيد موسي التي كانت الأمينة العامة المساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم قبل 2011، من تردّي الاوضاع الاجتماعية والحنين إلى الشعور بالأمن تحت رعاية نظام بوليسي، وهي تستند إلى ركيزتين: كراهية عميقة لجزء من الرأي العام تجاه حركة النهضة، ومساندة بعض النقابات الأمنية. ومنذ بداية الدورة التشريعية، تخصص موسي مع بقية نواب حزبها -وهم 16- نشاطهم لإعاقة عمل البرلمان. وقد ظهرت طوال أسابيع بمقر المجلس معتمرة خوذة ومرتدية سترة واقية من الرصاص، وكانت تقطع باستمرار سير الجلسات عبر مكبر صوت. هذه التصرفات الفوضوية تمنحها بعض الشهرة (سبر الآراء الأخير يضعها في المرتبة الاولى خلال الانتخابات التشريعية القادمة)، لكن لا يمنحها بالضرورة مصداقية كبيرة، حتى ضمن الكثير من الدستوريين القدامى الذين يعتبرونها وصولية.
إذا كانت اللحظة تستدعي قيصرا، فلا يبدو أن أيا من المرشحين قادرا على فرض نفسه كبديل للجمود الحالي. على المدى المتوسط، ترتفع أصوات منذ 2015 منادية بنظام رئاسي ليس على الطريقة الأمريكية، حيث يواجه الرئيس الكونغرس الذي يتمتع بوسائل مراقبة قويّة، ولكن لإعادة قصر قرطاج كمكان للإدارة الرسمية للدولة وغير الرسمية للتحكيم السياسي والاقتصادي، حتى تستعيد البلاد السلطة والنجاعة، مع أن الجائحة أثبتت أن النظام الرئاسي يضاعف من أخطاء القائد أكثر من ضمانه لفاعلية السياسات العامة.
تيري بريزيون
صحفي مراسل في تونس
————————-
“الحالة الاستثنائية” في تونس: الخلفيات والدلالات والآفاق
مساء الأحد، 25 يوليو/تموز 2021، أقدم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيِّد، على اتخاذ جملة من “الإجراءات الاستثنائية” وفق تأويله للفصل 80 من الدستور التونسي، حسب ما جاء في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي على إثر اجتماع عقده مع قيادات عسكرية وأمنية. وقد قضت هذه الإجراءات بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة ومباشرة رئيس الجمهورية مهام السلطة التنفيذية. كما أعلن الرئيس توليه مسؤولية النيابة العامة؛ ما يعني تجميع كافة السلطات في يده. ونظرًا لأثر هذه الإجراءات البالغ والمباشر على الوضع السياسي والاقتصادي وعلى مصير التجربة الديمقراطية التي نجحت تونس في الحفاظ عليها على مدى العشرية الماضية، فقد أثارت القرارات الرئاسية اهتمامًا واسعًا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
فقد فجَّرت جدلًا حادًّا حول دستورية هذه الإجراءات، تُرجم في شكل مواقف واصطفافات سياسية بين مؤيد ومعارض. فالمؤيدون، عمومًا، رأوا فيها انسجامًا مع الدستور واستجابة لمطالب شعبية بالتغيير ومحاربة الفساد رفعها المحتجون خلال التحركات التي شهدتها بعض المحافظات التونسية في الخامس والعشرين من هذا الشهر. والمعارضون، عمومًا، اعتبروها خروجًا عن الدستور وانقلابًا على المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مؤسسة البرلمان. أما الموقف الدولي، في مراكزه الأساسية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وإن لم يوصِّف ما جرى بالانقلاب، فقد دعا الرئيس إلى الالتزام بأحكام الدستور والعودة إلى المؤسسات الديمقراطية في أقرب الآجال. فكيف تطور الوضع السياسي إلى هذه الأزمة الحادة؟ وما محددات المواقف المختلفة إزاء هذه التدابير الاستثنائية؟ وما السيناريوهات المتوقعة لهذه التطورات في الأيام القادمة؟
خلفيات “التدابير الاستثنائية”
لا يمكن فهم الإجراءات التي أسماها الرئيس بالتدابير الاستثنائية بمعزل عن الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة والتي بلغت أوجها في الأسابيع الأخيرة مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل خطير ووصول المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار. ليست هذه الأزمة مفاجئة بل هي فصل جديد من أزمة هيكلية أعمق بدأت مع إعلان نتائج انتخابات 2019 التي أفرزت مشهدًا سياسيًّا وبرلمانيًّا متشظيًا. فالنظام الانتخابي المعتمد يميل إلى تشتيت الأصوات لتوسيع نطاق التمثيل، ويمنع الأحزاب الكبيرة من الفوز بأغلبية مريحة تمكِّنها من تشكيل حكومة مستقرة قادرة على الاستمرار والإنجاز وتنفيذ برامجها. وقد زاد من حالة الهشاشة غياب أحد أركان النظام السياسي الذي أرسته الثورة، وهو المحكمة الدستورية. وقد خلق غياب هذه المؤسسة، التي رفض الرئيس سعيِّد ختم قانونها الذي صادق عليه البرلمان في مايو/أيار الماضي، فراغًا دستوريًّا أفسح المجال أمام الرئيس لتأويل الدستور تأويلًا أحادي الجانب يرجِّح الكفَّة لصالحه في أي خلاف. وكان من تجليات هذا الخلل، على سبيل المثال، رفضه أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء بعد تحوير أجراه رئيس الحكومة المعفى، هشام المشيشي، ما جعل حكومته تعمل بنصف أعضائها في وضع شديد التأزم. تسبَّبت هذه العلاقات المتوترة بين رئيسي السلطة التنفيذية، ورئيس الدولة ومؤسسة البرلمان، الذي تشكِّل أغلبيته بقيادة حركة النهضة حزامًا سياسيًّا لحكومة المشيشي، من جهة أخرى، في خلق حالة من الارتباك وعدم الانسجام في عمل مؤسسات الدولة.
يُضاف إلى هذه الخلفية السياسية، تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والفشل الذريع في مواجهة جائحة كوفيد-19، ما جعل تونس من بين أسوأ بلدان العالم على هذا الصعيد بعد أن كانت قد سجَّلت نجاحًا استثنائيًّا في مواجهتها خلال الموجة الأولى قبل نحو عام. ومع اقتراب الذكرى 64 لإعلان الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز، شهدت العاصمة، تونس، وبعض المحافظات تحركات احتجاجية اتسمت في أغلبها بالعنف، وتخلَّلتها أعمال حرق ونهب لعدد من مقرات حزب حركة النهضة. لم تكن هذه التحركات عفوية، فقد وقع الإعداد لها بشكل مكثَّف خلال الأسابيع التي سبقت ذكرى إعلان الجمهورية، واشترك في الدعوة إليها بعض الوجوه السياسية إلى جانب مجموعات من الشباب الذي ينسب نفسه إلى الرئيس، قيس سعيد، ويضع في صدارة أولوياته حل البرلمان.
سجالات الفصل 80 حول دستورية “التدابير الاستثنائية”
في مساء الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وقبل أن تختفي مظاهر الحركة الاحتجاجية، عقد الرئيس سعيِّد اجتماعًا مع قيادات أمنية وعسكرية أعلن في خاتمته إجراءات ما سُمي بـ”الحالة الاستثنائية”. وقد استند في إعلانه تلك الإجراءات على قراءة خاصة لما آلت إليه الأوضاع تعتبر أن البلاد أمام “خطر داهم” يخوِّله تفعيل الفصل 80 من الدستور. وقد تضمنت تلك الإجراءات أربعة قرارات، أولها: تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، دون حلِّه، لأن الدستور لا يسمح للرئيس بحل البرلمان حتى في ظل الإجراءات الاستثنائية، بل يشترط أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم أثناء تلك الفترة. وثانيها: رفع الحصانة عن كافة أعضاء المجلس النيابي والبدء بتتبع كل من تعلقت به قضايا فساد أو نحوه. وثالثها: تولي الرئيس السلطة التنفيذية وإعفاء رئيس الحكومة وتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة. ورابع تلك الإجراءات: تولي الرئيس بنفسه مسؤولية النيابة العمومية.
وقد أثارت هذه القرارات الرئاسية جدلًا واسعًا بشأن دستوريتها، وما إذا كان الوضع بالفعل يستدعي تفعيل الفصل 80 من الدستور والدخول في حالة الاستثناء. ويمكن ترتيب الجدل الدائر حول قرارات الرئيس وفق ثلاثة مستويات: الشروط والإجراءات والصلاحيات. فعلى مستوى الشروط، يشترط الفصل 80 لتفعيله أن تكون البلاد بالفعل “في حالة خطر داهم مهدِّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة”. صحيح، ثمة ما يشبه الإجماع على أن تونس تمر بأزمة خانقة على جميع المستويات، ولكن تكييف هذه الأزمة على أنها “خطر داهم” يقتضي اتخاذ هذه “التدابير الاستثنائية” مثار جدل وموضع خلاف. وعلى مستوى الإجراءات، ينص الفصل 80 على ضرورة استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، قبل اتخاذ أي إجراءات استثنائية. وكان رئيس البرلمان قد صرَّح بأن رئيس الدولة لم يستشره في طبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها، ولا أحد يعلم إلى حدِّ الآن ما إذا كانت استشارة رئيس الحكومة قد حصلت، فالرجل مختف منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز بعد حضوره إلى قصر قرطاج، وسط أنباء عن ضغوط مورست عليه وصلت حدَّ إهانته وتعنيفه جسديًّا، نفى صحتها المشيشي في بيان مكتوب لكن استمرار تواريه عن الأنظار يلقي شكوكًا على تمتعه بحرية التصرف. أما إعلام رئيس المحكمة الدستورية فلم يكن ممكنًا حصوله بحكم غيابه وغياب المؤسسة التي يرأسها.
وعلى مستوى الصلاحيات، يتعلق الجدل بطبيعة الإجراءات الاستثنائية وحدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس بمقتضى الفصل 80. فالفصل صريح في التنصيص على ضرورة بقاء مجلس الشعب منعقدًا أثناء الفترة الاستثنائية، بينما عطَّل الرئيس انعقاد البرلمان وأغلقه أمام النواب ووضع على بوابته قفلًا ودبابة عسكرية. وليس في الدستور ما يمنح الرئيس الحق في رفع الحصانة عن النواب؛ إذ البرلمان وحده مخوَّل بهذه الصلاحية دون غيره. كما أن الدستور، الذي يؤكد على فصل السلطات، لا يعطي الحق لرئيس السلطة التنفيذية في تولي النيابة العامة التي هي من اختصاصات السلطة القضائية. وقد أكد المجلس الأعلى للقضاء، إثر إعلان “التدابير الاستثنائية”، على هذه المسألة وتمسك باستقلاليته داعيًا الرئيس إلى عدم التدخل في سلطة لا تعود إليه.
لم يلبث الجدل، بمستوياته الثلاث، أن خرج من دائرة التأويل الدستوري للفصل 80 إلى اعتبار البعض أن ما أقدم عليه الرئيس خرق للدستور وانقلاب عليه وعلى المسار الديمقراطي ومؤسساته. وقد تُرجم هذا الجدل سياسيًّا في اختلاف المواقف من “الإجراءات الاستثنائية”، سواء على المستوى الوطني أو العربي والدولي.
مواقف مختلفة من التدابير الاستثنائية
نظرًا إلى أن الرئيس سعيِّد قد أقدم على اتخاذ إجراءاته في ظل توتر متصاعد وانقسام سياسي ومجتمعي داخلي، فقد اختلف التعامل مع تلك الإجراءات اختلافًا بيِّنًا وفق المواقف الثلاث التالية:
– اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس كان ضروريًّا، وأن خطوته جاءت وفق الفصل 80 من الدستور وأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها تدخل في صلاحياته، ولذلك وجب دعمه. على المستوى السياسي، تكاد حركة الشعب، ذات التوجهات القومية، تنفرد بهذا الموقف الداعم دون تحفظ.
– اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس كان ضروريًّا ويجده مبرراته في الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس والتي تسببت فيها المنظومة الحاكمة، ولكن الإجراءات التي اتخذها تحتاج إلى ضمانات لضبطها مع الدعوة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتوضيح خارطة الطريق التي ستعيد البلاد إلى الوضع الطبيعي واستئناف المسار الديمقراطي في أقرب الآجال. تشترك في هذا الموقف بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أعلن بدوره العمل على إعداد خارطة طريق للفترة القادمة.
– اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس لم يكن تفعيلًا للفصل 80 من الدستور نظرًا لغياب الشروط وعدم احترام الإجراءات التي ينص عليها، بل هو انقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة والمسار الديمقراطي. لذلك لابد من إنهاء حالة الاستثناء وفتح البرلمان والعودة السريعة إلى الوضع الطبيعي. تشترك في هذا الموقف بشكل أساسي الأحزاب التي تدعم الحكومة وفي مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، إضافة إلى بعض الأحزاب غير البرلمانية مثل حزب العمال والجمهوري والقطب والاتحاد الشعبي الجمهوري، كما تشترك فيه بعض الهيئات والشخصيات الوطنية والأكاديمية.
أما على الصعيد الخارجي، فثمة ما يشبه الإجماع، باستثناء عدد محدود من الدول العربية التي عُرفت بموقفها المناهض للديمقراطية والربيع العربي، على أن ما أقدم عليه سعيِّد يدعو للقلق وعدم الارتياح خاصة بعد جمع الرئيس لكل السلطات بين يديه؛ ما يشير إلى إمكانية عودة تونس إلى الحكم الاستبدادي. على هذا الصعيد، دعت كل من ليبيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إلى احترام الدستور والنظام الديمقراطي والسماح بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي وعلى رأسها مؤسسة البرلمان.
في خضم هذا التفاعل الذي شهدته مواقف مختلف الأطراف على المستويين الداخلي والخارجي، يظل الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية، على وجه الخصوص، غامضًا ولم يظهر منه ما يفيد الانخراط فيما اعتبره البعض انقلابًا على النظام الديمقراطي. فالجيش التونسي، المعروف بمهنيته العالية وحياده إزاء الخلافات السياسية، لم ينتشر في الشوارع، ولم يستول على المؤسسات ولم يستلم إدارة البلاد، ولكن في الآن نفسه، قامت وحداته بتنفيذ بعض الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس مثل غلق البرلمان ومنع نواب الشعب من دخوله لمواصلة أعمالهم حسبما يقتضيه الدستور. وبقطع النظر عن طبيعة السيناريوهات المستقبلية الممكنة، يظل موقف المؤسسة العسكرية محدِّدًا فيما سيؤول إليه الوضع في قادم الأيام.
سيناريوهات واحتمالات
بعد مضي أكثر من أسبوع على الشروع في تطبيق “التدابير الاستثنائية”، لا يزال الوضع في تونس غامضًا، ولا تزال الخطوات التي يسلكها الرئيس مترددة وتوحي بالارتباك وغياب الخطة. بالمقابل، يستمر الانقسام في الشارع التونسي وفي أوساط النخبة السياسية حول ما جرى، مع اتساع مطَّرد في دائرة المواقف المناهضة لهذه الإجراءات والداعية للالتزام بأحكام الدستور، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، والخروج من وضع الاستثناء في أسرع الآجال. في هذا السياق يمكن أن نرسم السيناريوهات الثلاث التالية:
1. فشل ما سُمي بـ”الانقلاب” بعد عجز الرئيس عن تنفيذ كل ما كان ينوي تنفيذه في المدة المحددة؛ ما يعني التراجع التدريجي عن بعض الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بسير البرلمان. قد يجد الرئيس فيما حققه إلى حدِّ الآن (ذهاب المشيشي وحكومته) مكسبًا يبرر له ولداعميه التراجع أو التوقف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية، لاسيما في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وصعوبة التعامل مع الواقع الاقتصادي الخانق المرتبط عضويًّا بصناديق المانحين وبالمؤسسات المالية العالمية. في هذا السياق، قد تنجح جهود الوساطة الإقليمية في إقناع سعيِّد والقوى المؤثرة في البرلمان بتشكيل حكومة توافقية، يتوزعون حقائبها الوزارية، ويستأنف البرلمان عمله لمنحها الثقة، أو المضي إلى الحوار الوطني الشامل، على توزيع السلطات في النظام السياسي، أو الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة للاحتكام مجددًا للشعب التونسي، وإن كان هذا الخيار الأقل احتمالًا من بين الثلاثة، وكان خيار التوافق على تشكيل حكومة توافقية أوفرها حظًّا.
قد يكون هذا السيناريو الأكثر رجحانًا لأن القوى التي تدعمه داخليًّا وخارجيًّا بالغة التأثير.
2. المضي في خطة “الانقلاب” إلى نهايتها مع تصعيد تدريجي وتوسيع لدائرة الإجراءات الاستثنائية، خاصة في غياب أية مقاومة ميدانية وشعور الرئيس بأن مستوى الضغط الحالي ليس كافيًا لإجباره على التراجع. سيفضي تطبيق هذه الخطة إلى إجهاض المسار الديمقراطي والدخول في أعمال انتقامية واعتقالات سياسية واسعة بتوظيف القضاء والأمن، وربما ينتهي الأمر بحل بعض الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تقف في الضفة المقابلة لتوجهات الرئيس وخياراته السياسية. هذا السيناريو يتقدم ببطء ولكن الدفع المحموم في هذا الاتجاه من قبل بعض القوى الإقليمية قد يسرِّع من خطواته في الأيام القادمة.
3. التصدي للانقلاب من خلال حشد الشارع في تحركات ميدانية قد تتسبب في تفجير العنف وتعميم الفوضى، أو إفشال الانقلاب وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الإجراءات الأخيرة. هذا السيناريو مستبعد في الوقت الراهن، خاصة بعد دعوة حركة النهضة، القوة السياسية والشعبية والتنظيمية الأولى، أنصارها للانسحاب من الشارع منذ اليوم الأول. وسيكون صعبًا على أي طرف تعبئة الناس من جديد للتصدي لهذه الإجراءات خاصة في ظل حالة الطوارئ ومنع التجمع والجولان، الذي أعلن عنه الرئيس في السادس والعشرين من يوليو/تموز الجاري. ولكن هذا السيناريو يمكن أن يستعيد زخمه إذا ترجح السيناريو الثاني وطال أمد حالة الاستثناء، واتخذت الإجراءات الرئاسية شكلًا انتقاميًّا تنتصب بمقتضاه محاكمات سياسية واسعة النطاق تهدد استقرار البلاد وتسعى للإطاحة بالمنظومة السياسية برمتها.
——————————-
مواقف رئيس هيئة الانتخابات في تونس تثير تساؤلات حول حيادها
وقّع مثقفون وإعلاميون عريضة تعتبر إجراءات سعيد الاستثنائية “خرقاً جسيماً للدستور وانقلاباً عليه”.
يُعرّف القانون المحدِث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها “هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، مقرها تونس العاصمة وتسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة”.
ويضمن قانون الهيئة استقلاليتها عن كل الأطراف السياسية المتدخلة في العملية الانتخابية ضماناً لنزاهة وشفافية الانتخابات، فهل حافظت هيئة الانتخابات على حيادها واستقلاليتها إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد؟
الهيئة في حال صدمة
غداة إعلان الرئيس التونسي قراراته الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، أعرب رئيس الهيئة نبيل بفون عن صدمته من تلك الإجراءات واعتبرها خارجة عن الدستور.
وقال بفون “إن الهيئة في حال صدمة بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي”.
واعتبر رئيس الهيئة أن “ما صدر من قرارات عن رئيس الجمهورية غير مطابق لأحكام الدستور التونسي الذي يحدد صلاحيات الرئيس بحسب الفصلين 71 و78 من الدستور، لا سيما تفعيل الفصل 80 عند الخطر الداهم” مشيراً إلى أن “تفعيل الفصل 80 يتضمن الإبقاء على مجلس نواب الشعب في حال انعقاد دائم”.
استبعاد الانتخابات المبكرة
وأكد بفون أنه “بحسب الإجراءات الاستثنائية للفصل 80 من الدستور لا يجب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، إلا أن قيس سعيد ألغاها بصفة نهائية وجمد أعمال البرلمان”، مؤكداً أن “هذه القرارات غير متطابقة مع الدستور التونسي ومن شأنها إرباك المسار العادي للدولة”.
كما رجح بفون إمكان دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم انتخابات مبكرة، إلا أن الدستور التونسي هو الذي سيحدد المسار الانتخابي قائلاً إنه “لا يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري”، مضيفاً أن “تنظيم انتخابات مبكرة يكون في حال حل البرلمان الذي له شروط لم تتوافر حتى الآن”.
وأثار تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلاً، وأعاد طرح السؤال حول مدى استقلاليتها عن الأحزاب وبخاصة حركة النهضة.
تصريحات مسيئة لاستقلالية الهيئة
ووصف أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ “الصادمة” والموجبة للمؤاخذة القانونية، مشيراً إلى أن “من شأن هذه التصريحات أن تسيء لسمعة الهيئة كجهاز مستقل”.
واستغرب الخرايفي أن يحشر بفون نفسه في المعارك السياسية، داعياً إياه لأن يكون على المسافة نفسها من كل الطيف السياسي، مؤكداً أن “هيئة الانتخابات هي هيئة الدولة التي لا تتأثر بالمزاج السياسي العام أو بالتقلبات الحزبية، وعندما ينحاز رئيس الهيئة إلى جهة سياسية معينة فيكون مس بمبدأ الحياد واستقلالية الهيئة”.
وشدد أستاذ القانون على أن رئيس الهيئة لم يعد محل ثقة، داعياً إياه إلى “تقديم استقالته لأنه تصرف وكأنه جزء من الائتلاف الحاكم”، معتبراً أن “تصريحاته موجبة للمؤاخذة القانونية”.
ولفت الخرايفي إلى أن “طبيعة الأحداث وتسارعها في تونس من قرارات استثنائية وإقالات غطت على تصريح نبيل بفون على الرغم من خطورته”.
احترام مبدأ الحياد
ودعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل الهيئات الدستورية إلى “الالتزام بواجب الحياد والنزاهة والتحفظ والابتعاد عن الاصطفاف السياسي والحزبي، والنأي بهذه الهيئات عن التجاذبات السياسية”.
وانتقدت الجمعية في بيان تصريح نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المنتهية ولايته) حول التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي، داعية إياه إلى “احترام مبدأ التحفظ وعدم إبداء رأيه وإن كان بصفته الشخصية”.
“عريضة وطنية مفتوحة”
من جهة أخرى، استنكرت الجمعية توقيع عضو الهيئة عادل البرينصي على “عريضة وطنية مفتوحة” بصفته إعلامياً، معتبرة أن عدم حياديته تعد “خطأ جسيماً” يوجب الإعفاء، كما ينص القانون المنظم للهيئة.
ووقع مثقفون وإعلاميون تونسيون العريضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد “خرقاً جسيماً للدستور وانقلاباً عليه وعلى مقتضياته، إضافة إلى أن جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه يُعد مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقرّه الدستور التونسي وكل الدساتير الديمقراطية”.
وحذرت العريضة من “أن يؤدي هذا الاستحواذ على كل سلطات الدولة إلى إقامة نظام استبدادي”، وعبروا عن تخوفهم من التعديات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام.
يُذكر أن قانون الهيئة في فصله الـ 12 ينص على أن “رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خاضعون لواجب التحفظ والحياد”.
وانتُخب نبيل بفون على رأس الهيئة في آخر يناير (كانون الثاني) 2019، وهو معني بالتجديد الآلي خلال عام 2020، وانتهت رئاسته للهيئة بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية لعام 2019، إلا أن مجلس النواب لم يخصص جلسة لتجديد ثلث مجلس الهيئة الذي يتم كل سنتين بحسب القانون.
اندبندنت عربية
—————————–
النهضة تنقلب على اعترافها بقرارات قيس سعيد تحت ضغوط داخلية
الحركة اعتبرت قرارات سعيد فرصة للإصلاح داعية لان تكون إجراءاته مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي لتتراجع عن ذلك تحت ضغوط من قيادات في مجلس الشورى.
النهضة تفقد هامش المناورة
تونس– عادت حركة النهضة عن اعترافها وإقرارها بقرارات الرئيس قيس سعيد وسط تجاذبات داخلية كبيرة بين أجنحتها من خلال الخلافات في اجتماع مجلس الشورى الذي انعقد برئاسة رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي الأربعاء
وكانت حركة النهضة نشرت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك تدوينة اعتبرت فيها ان قرارات الرئيس جزء من الإصلاح وانه يمكن ان تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي قبل ان يتم حذف التدوينة.
وطغى الارتباك والانقسام على موقف حركة النهضة مع اجتماع مجلس شورى الهيئة الأعلى في الحزب في ظل أسوأ أزمة تضرب الحركة منذ 2011 وتضع مستقبلها السياسي على المحك.
ونقل القيادي البارز في الحركة محمد سامي الطريقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن الغنوشي بانه ” علينا ان نحول إجراءات 25 يوليو الى فرصة للإصلاح ويجب ان تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي قبل ان يتراجع بدوره.
وبعد ساعات سحب الطريقي التدوينة لينشر أخرى حاول فيها التراجع عما عما صدر منه سابقا بعد ضغوط من الأطراف المحيطة بالغنوشي.
وقال الطريقي في توضيحه لتدوينته ” لم يذكر رئيس الحركة أن ما وقع هو تحول ديموقراطي إنما قلت يجب ان تصبح تلك الإجراءات ضمن المسار الديموقراطي وان لا يخرج عنه.
وأضاف ” يجب ان تكون تلك التدابير الاستثنائية المعلنة في حدود ما أعلنته و ضمن سياقها الزمني وان تكون فعلا فرصة للإصلاح كذلك بالعودة إلى السياق الدستوري واسترجاع المؤسسات الدستورية”.
وأعلنت كل من العضوتين في مجلس شورى النهضة يمينة الزغلامي وجميلة الكسيكسي انسحابهما من الدورة الاستثنائية للمجلس.
وأكدت العضوتان أنهما لا تتحملان مسؤولية أية قرارات ستصدر عن مجلس الشورى وان القرارات لا تلزمهما.
وقالت يمنية الزغلامي “أعلن الآن انسحابي من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى ولا اتحمل مسؤولية أيّ قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد مضيفة “لن أكون شاهدة زور”.
من جهتها أعلنت النائبة جميلة الكسيكسي بدورها انسحابها من الدورة .
وأفادت الكسيكسي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك “أعلن انسحابي من دورة الشورى وآي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمني” مضيفة “كل الخير لتونس، كل الحب لشعبنا ويبقى الأمل”.
بدوره عبر القيادي في النهضة سمير ديلو عن غضبه الشديد من مواقف مجلس الشورى قائلا بانه “حالة انكار”.
وعكست تصريحات قياديين بارزين في الحركة تراجعا في حدة الانتقادات الموجهة لقيس سعيد في وقت تتالت فيه الدعوات إلى تغييرات جذرية في قيادة الحركة بعد استقالة القيادي خليل البرعومي من المكتب التنفيذي للحركة، محملا الغنوشي جانبا كبيرا من تأزم الأوضاع على الساحة السياسية.
وكان القيادي في الحركة عماد الحمامي قد فجّر مفاجأة بتصريحات أكد فيها أن الرئيس سعيد فعل ما كان يتوجب فعله بخصوص تفعيله للفصل 80 من الدستور.
ووصف الحمامي القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بالشجاعة، مؤكدا أن قيس سعيد تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل من أجل الذهاب نحو ديمقراطية حقيقية.
ومن جانبه وصف القيادي سمير ديلو تصريحات الرئيس “بالمطمئنة”، رافضا دعوة الغنوشي لأنصار الحركة للنزول إلى الشوارع، معتبرا أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن “خط أحمر”.
وقبل اجتماع مجلس الشورى تواترت تصريحات بالدعوة إلى إصلاحات داخلية قد تشمل القيادة، وكان هذا محور رسالة وقعها العشرات من أعضاء الحزب الشباب في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع يوم 25 يوليو ضد البرلمان وحكومة هشام المشيشي المقالة.
وأصدر عدد من شباب حركة النهضة عريضة داخلية بعنوان “تصحيح المسار” دعوا فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل “مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي”.
ويؤشر تصاعد الدعوات داخل حركة النهضة المنادية برحيل زعيمها راشد الغنوشي، على ترهل قاعدتها في خضم الانشقاقات المتتالية التي تشهدها.
العرب
—————————
تونس… ماذا جرى في قصر قرطاج؟/ محمد قواص
بثّت الفضائيات في كانون الثاني (يناير) من عام 2011 مشهداً سريالياً (يكاد يكون هوليوودياً) لمواطن تونسي يردد في شارع ليلي خلا من المارة قولته الشهيرة: “بن علي هرب، بن علي هرب”. بدا أن “ثورة الياسمين” التي فجّرتها حادثة مقتل الشاب محمد البوعزيزي (أمام مقر ولاية سيدي بوزيد في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، قد نجحت في إسقاط النظام في تونس وهجرِ الرئيس منصبه وقصره وحكمه.
غير أن الخاتمة الحميدة لثورة الناس بدت، لمعارضي زين العابدين بن علي قبل مواليه، مفاجِئة صاعقة غير متوقعة، على الأقل بهذه السرعة غير المبررة. كانت كل مؤسّسات البلاد آنذاك تعمل، والتحركات الشعبية تحت السيطرة. كما أن تجمعات الناس، على أهميتها وشيوعها، في مدن تونس، وخصوصاً في العاصمة، لم تكن بعد لتشكل خطراً وجودياً على النظام، ولم تكن تهدد يقينا أمن الرئيس وحياته. ومع ذلك فإن “بن علي هرب”.
تجاوزت تونس على نحو مريب هذا السرّ الغامض، اعتبرته تفصيلاً ودليلاً على هشاشة النظام الذي يحكم البلد، وراحت تجترح عملية سياسية بديلة تحت عنوان “التحوّل الديموقراطي”. وبدا أن حكام البلاد الجدد قد تلقوا بركة خارجية “جبارة” تغضّ الطرف عن “انقلاب” ما، غير دستوري، وله أدوات أمنية عسكرية، أطاح على عجل رئيس البلاد مسوّقاً الأمر وفق إطار “الثورة” و “رغبة الجماهير”. وبناء على قواعد ذلك “الانقلاب” المحتمل قام النظام السياسي الذي حكم تونس منذ عشر سنوات.
لا أحد في تونس، لا الموالون لبن علي ولا معارضوه، أثار مسألة حدوث “انقلاب” في تلك الليلة التي حملت بن علي على مغادرة البلاد على عجل. وحده عبدالفتاح مورو لمّح إلى الأمر وكرر تناول الحدث بصفته غموضاً لا أحد يريد فضح حقيقته.
التقيت الشيخ عبدالفتاح مورو في تونس في خريف عام 2014. الرجل محامٍ وداعية وشخصية مشهورة في تونس وخارجها وصاحب كلمة حرة وجريئة ومثير للجدل في تناول مسائل السياسة والدين، ولطالما كان معارضاً لشعار “الإسلام هو الحل”. عرفته البلاد داخل “الاتجاه الإسلامي” ثم أحد المؤسسين لـ “حركة النهضة” مع الشيخ راشد الغنوشي. شغل مورو منصب نائب رئيس الحركة وكان مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية عام 2019 والتي فاز بها قيس سعيد بنسبة ساحقة تجاوزت 72 في المئة. قدم مورو استقالته من “حركة النهضة” في أيار (مايو) 2020.
في مقابلتي معه قال مورو: “إننا لا نعرف ماذا حدث في قصر قرطاج” عشية الإعلان عن مغادرة بن علي البلاد في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وأضاف أن الحشود الهائلة في تونس العاصمة كانت على بعد 17 كلم من قصر قرطاج، وبن علي في قصره كان محاطاً بقوة حماية يصل تعدادها إلى ثلاثة آلاف جندي من الصفوة، بما كان يبعد عنه هذا الخطر الداهم الذي يضطره إلى الفرار.
لم يكن الشيخ المحامي يتحدث في اجتماع مغلق، بل هي تصريحات علنية متلفزة يمكن متابعتها على شبكات الانترنت. لم يلفظ مورو كلمة “انقلاب”، لكنه تحدث عن “ميكانيزمات غامضة” أجبرت بن علي على مغادرة البلاد على هذا النحو المفاجئ للجميع. وحين سألتُه عما منع “حركة النهضة” التي تشارك بالحكم منذ سقوط بن عن من إماطة اللثام عما حدث في قصر قرطاج، قال إن الأمر ما زال غامضاً.
قامت “الديموقراطية” في تونس وصفقات الحكم بعد “ثورة الياسمين” على قاعدة غموض “ميكانيزمات” جرى التكتم عليها توحي بأن انقلاباً أطاح بن علي. وفيما أن هذه العتمة هي مصدر السلطات التي قادت البلاد إلى تجربة ملتبسة مثيرة للجدل قادت إلى الفشل، فإن ما يصدر عن قصر قرطاج هذه الأيام، أياً كان تقييمه والجدل حوله، يجري بشكل مفرط في الشفافية التي لا تترك لأشد خصوم الرئيس قيس سعيد حججاً مناوئة ذات صدقية. حتى تهمة الانقلاب تكاد تكون حجّة متعجلة متصدّعة يشوبها تلعثم شديد يصعب الدفاع عن صحتها.
ولئن تعتبر قصة صعود قيس سعيد ظاهرة نادرة في اختراقه، وحيداً، وبدأب تفصيلي، كل الطبقة السياسية القديمة والطارئة، إلا أن شفافية الرجل تكاد تفيض بحيث أن لا أسرار تحيط به ولا كواليس يدبر خلفها مواقفه. كشف قيس سعيد المرشح عن آرائه وأسلوبه ووعوده، وراح قيس سعيد الرئيس بنفس النمط والشفافية يعبر عن مواقفه “على الهواء مباشرة”، ويصادم ما يتنافى مع مصالح البلد، بحسب رأيه. ومن يراقب أداءه منذ ما قبل القرارات التي بدأ باتخاذها في 25 تموز (يوليو) الماضي يسهل عليه استبعاد أي غشاوة تقف وراء هذا التحول المفصلي في تاريخ البلاد.
دشّنت “ثورة الياسمين” التونسية، في أواخر عام 2010 حتى نهايتها أوائل عام 2011، حقبة ما سمّي بـ “الربيع العربي”. وفيما عبّر “الربيع” في بعض البلدان العربية عن حراك عفوي أصابته عدوى الحدث التونسي، بدا أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك ترعى إنعاش جماعات الإسلام السياسي لا سيما “الإخوان المسلمين” وجعلها قاطفة لثمار “الفوضى الخلاقة” التي كانت بشّرت بها عام 2005 كونداليزا رايس الى “واشنطن بوست” حين كانت وزيرة للخارجية الأميركية آنذاك. وكانت راجت في الأروقة الأكاديمية خلال السنوات التي سبقت “الربيع” مفاهيم توصي بتسليم المنطقة لـ “إسلام معتدل” يكون قادراً على استيعاب جماعات الجهاد والإرهاب.
بدا أمر الانعطاف “الإسلاموي” أكثر وضوحاً في الحالة المصرية لاحقاً، بما يؤكد أن ما حصل في قصر قرطاج في تونس عشية رحيل بن علي كان متأثراً بإرادات التحول الجبارة التي ترسمها الولايات المتحدة في المنطقة. كانت “ويكيليكس” قد كشفت في مراسلات هيلاري كلينتون ما يتطابق مع هذه التحولات في تونس. ولاحقاص نقل عن بن علي حديثه عن خدعة تعرّض لها محملاً مسؤولية رحيله إلى قرار أميركي.
ما تغيّر على قصر قرطاج هذه الأيام هو سلسلة من التحولات. تلك التي شهدتها تونس في تجاربها الممتدة على مدى العشر سنوات المنصرمة، بما في ذلك تجربة “حركة النهضة” في الحكم. وتلك التي شهدتها بلدان المنطقة التي أسقطت نهائياً “الترياق” الإسلاموي. وتلك التي شهدها العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة نفسها، والذي بات يتعامل مع المنطقة وفق معطياتها وليس وفق المعطيات التي تُراد لها.
في تونس من حذّر التونسيين من عنف وإرهاب ومن أنذر الأوروبيين بطوفان من اللاجئين. غير أن تونس تغيرت وبات الشيخ عبدالفتاح مورو والشعب التونسي يعرفون بدقة ما يجري في قصر قرطاج من دون لبس أو غموض.
النهار العربي
————————–

===========================
تحديث 06 آب 2021
—————————-
أعداء لا خصوما: هل الخلاف بين الإسلاميين ومناهضيهم قابل للحل؟/ محمد سامي الكيال
تذكّر التطورات الأخيرة في تونس بسيناريو يتكرر دائماً، وبشكل شبه حرفي في العالم العربي: يتم إفساح المجال لانتخابات، تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والمصداقية، نتيجة تغيير في الأنظمة السياسية القديمة، أو حراك شعبي ناجح، فتفوز فيها قوى إسلامية، تتفاوت في مدى اعتدالها أو تطرفها، وتسيطر على السلطة التشريعية، وأحياناً جانب من السلطة التنفيذية، لترتفع بعدها حدة الصراع الاجتماعي والسياسي، ويُتهم الإسلاميون بالسعي لأسلمة جهاز الدولة والمجتمع، والهيمنة على مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن الفشل والفساد الإداري، وفي الختام تحدث حركة انقلابية ما، غالباً عبر الجيوش، كما في حالة الجزائر ومصر، أو عبر قوى وشخصيات، تتمتع بدورها بشرعية شعبية معينة، مثل حركة فتح في فلسطين، أو الرئيس التونسي قيس سعيد، تُقصي الإسلاميين عن جانب من السلطة، وتُدخل البلاد في ديكتاتورية شديدة الوطأة، أو حالة من الفوضى والاقتتال الأهلي، وهو ما لا يتمناه أحد في الحالة التونسية.
توجد مقاربتان أيديولوجيتان لوصف هذا السيناريو المتكرر: الأولى مدنية أو «علمانية» ترى أن الصراع يدور حول مفهوم الدولة الحديثة نفسه، فالإسلاميون يسعون دوماً إلى نزع مدنية الدولة، من خلال ضرب مفاهيم أساسية فيها، مثل الانتماء الوطني والحريات الفردية ومعاداة الطائفية، ما سيدخل البلاد في حالة من الهيمنة الثيوقراطية، تؤدي إلى اضطرابات أهلية شديدة، والحل هو الدفاع عن الدولة المدنية الحديثة، ضد النزوع الثيوقراطي قبل الحديث للإسلاميين، مهما كان الثمن؛ أما المقاربة الثانية فيتقاسمها الإسلاميون وكثير من الليبراليين واليساريين المعتدلين، تؤكد أن الصراع يدور حول مفهوم الديمقراطية نفسه، إذ يجب على كل القوى التحاكم إلى الشرعية المؤسساتية والدستورية، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، حتى لو أدت إلى وصول قوى محافظة، أو رجعية إلى السلطة، ومن ثم العمل على التغيير بالأساليب الشرعية، لتجنيب المجتمعات خطر العودة للحكم الديكتاتوري، والانجرار للحروب الأهلية.
وعلى الرغم من أن كلا المقاربتين لا تخلوان من وجاهة ما، إلا أنهما تعانيان من بعض الاضطراب المفاهيمي، الذي يدفع لطرح عدد من الأسئلة: إذا كان الصراع حول وجود الدولة المدنية الحديثة من عدمه، فلماذا يتركّز صراع الإسلاميين مع خصومهم على قضايا مثل المؤسسات والقوانين والدساتير ومفهوم الشعب والهوية الثقافية والوطنية، وهي كلها قضايا لا وجود لها خارج نموذج الدولة الحديثة؟ من جهة أخرى إذا كان الصراع حول تقبّل النظام الديمقراطي، فلماذا تبدو الديمقراطية العربية عاجزة عن تأمين ضمانات للفئات التي تخشى سيادة الإسلاميين؟ أليس توفير مثل هذه الضمانات يعتبر الحد الأدنى لوصف الديمقراطية بـ»النظام السياسي» أي معادلة تحقق تسويات وتوازنات بين القوى الاجتماعية، وتقاليد وأعرافاً في الحيز العام، تتمتع بشيء من الاستقرار والديمومة؟
عداء حتمي
يصعب اعتبار أن الأنظمة السياسية المستقرة قائمة على إلغاء الصراع الاجتماعي، أو استبداله بنمط من التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والمصالح، إلا أن ما تؤمّنه المؤسسات والتقاليد السياسية أساساً قنوات للتواصل والتفاعل، ومرجعيات معترف بها، ولو بشكل نسبي، تساهم في الفصل في النزاعات أو تجميدها بشكل سلمي، ما يضمن عدم تحوّلها إلى حروب إلغاء بين مختلف الفرقاء، ويجعلهم خصوماً وليسوا أعداء. أما كيفية نشأة تلك المؤسسات والتقاليد، والأسس التي تقوم عليها، فهو موضوع مفضّل للنظرية السياسية، تختلف فيه وجهات النظر إلى حد كبير.
في كل الأحوال يصعب إيجاد نظرية جديّة، تنسب المؤسسات الديمقراطية إلى أصل جوهراني أو طبيعي ما، يُغني عن دراسة الجذور التاريخية لنشأتها، والفئات والقوى الاجتماعية، التي فرضتها في حقبة معينة، فحتى النظريات، التي تتحدث عن نمط من العقلانية الاجتماعية بين الذاتية، الموجودة في اللغة والتواصل الإنساني نفسه، تؤكد دور ظهور «الجمهور البورجوازي» في تأسيس حيز عام حديث، ساهم في بناء وترسيخ مؤسسات الديمقراطية الليبرالية.
بهذا المعنى فالحديث عن ديمقراطية مغدورة في العالم العربي، بسبب نزوع أعداء الإسلاميين للانقلاب على مفهوم جاهز لـ»الديمقراطية» يصوّر النظام الديمقراطي وكأنه وصفة متعالية عن الصراع الاجتماعي، وتوزّع القوى السياسية المختلفة ضمنه، ربما كان الأجدى التساؤل عن أسباب فشل الإسلاميين، رغم ادعاء كثير من أنصارهم، وحتى بعض خصومهم، تمثيلهم لـ»ثقافة المجتمع» في فرض هيمنة أيديولوجية، تمكّنهم من تأسيس «حس سليم» ما، يتحاكم إليه الخصوم السياسيون في نزاعاتهم؛ ويمهّد لنشوء مؤسسات سياسية مستقرّة.
أياً كانت الإجابة، وحتى لو اقتنعنا بأن السبب طول فترة تحكّم الأنظمة الديكتاتورية، وقمعها للإسلاميين وغيرهم، فهذا لا يغيّر كثيراً من الواقع الذي يشير إليه ذلك التساؤل، وهو أنه لا توجد حالياً قوة اجتماعية أو سياسية قادرة على تحقيق السيادة والهيمنة المطلوبتين لنشوء نظام ديمقراطي مستقر، ما يبقي الأوضاع في المجتمعات العربية مفتوحة على صراعات غير مؤطرة بحدود وقنوات، تضمن التداول السلمي للسلطة، والحريات السياسية لمعظم القوى الاجتماعية، ويجعل المتصارعين في الميدان السياسي أعداء بالضرورة، يسعون لفرض هيمنتهم بمختلف الوسائل الممكنة، وليسوا خصوماً. ولذلك فليس من المستغرب أن يتعاون «المدنيون» مع العسكر أو القوى الخارجية، لمنع إلغائهم من قبل الإسلاميين؛ أو أن يلجأ الأخيرون إلى استخدام شرعية الصناديق الانتخابية لفرض أنظمة تسلّطية، لا تؤمّن أياً من الضمانات والحقوق المعروفة في الأنظمة الديمقراطية المستقرّة.
المقاربة الشكلانية للديمقراطية، بوصفها مجرد مجموعة من الإجراءات والقواعد والمؤسسات والنصوص دستورية، ستصدم غالباً بواقع مخيّب للآمال، قد يدفع إلى اعتبار المجتمعات العربية غير مهيئة بطبعها للتحول الديمقراطي، ولذلك فربما كان من الأفضل إيجاد منظور آخر للديمقراطية، يعتبرها نتيجة ممكنة لصراع اجتماعي متعيّن في مجتمع ما، الأمر الذي يتيح طرح سؤال قابلية المجتمعات العربية للديمقراطية بشكل مختلف، يقوم أساساً على محاولة معرفة ما الذي يدور حوله الصراع السياسي والاجتماعي حالياً في أغلبية الدول العربية.
نزاع الحداثات
يشترك الإسلاميون وخصومهم «المدنيون» بالتركيز على هدف واضح المعالم، وهو السيطرة على جهاز الدولة الحديثة، بما يملكه من إمكانيات هائلة للتحكّم بالأحوال الحياتية العامة للسكان، ومنها مستوى الحياة، الأوضاع الصحية، الأحوال الشخصية وأنماط السلوك الفردي. وبالتالي فالصراع ليس حول قبول الحداثة أو رفضها، بل بين منظورات متعددة للتحديث، تجعل من الهوية و»ثقافة المجتمع» موضوعاً لهندسة اجتماعية وسياسية – حيوية، تجريها الدولة الحديثة.
يرتبط هذا الصراع بأزمات شديدة تعاني منها المجتمعات العربية، وعلى رأسها النمو السكاني، وانفجار حيوية مجتمعات شابة، في تشكيلات اجتماعية – اقتصادية على هوامش المنظومة العالمية، تتكثّف فيها كل المشاكل البنيوية لهذه المنظومة، وعرفت انهيارات كبيرة عقب الأزمات الكونية الأكبر، مثل الأزمة المالية العالمية وانتشار فيروس كورونا.
فضلاً عن هذا تعيش الدول العربية الشرط السياسي المعاصر بامتياز، من تراجع التنظيمات السياسية الكلاسيكية، مثل الأحزاب والنقابات، مع انحلال المواطن التقليدية للعمل واللقاء الاجتماعي، ما يجعل خريطة التوزّع السياسي والطبقي شديدة الاضطراب، ويعرقل نشوء قوى اجتماعية منظّمة واعية لذاتها، مؤدياً لبقاء الاحتجاجات الاجتماعية موضعية وسريعة التبدد، خاصةً بعد أن أثبت نمط التنظيم الموصوف بـ«الشبكي» و«غير الهرمي» فشله في التغيير الفعلي.
ضمن هذا الشرط تحوي ائتلافات المدنيين والإسلاميين خليطاً طبقياً غير متسق، من فئات اجتماعية تفشل في الحفاظ على أنماط حياتها ومستواها المعيشي، ما يدفعها لتفريغ غضبها وخيبتها بأسلوب عنيف أحياناً، وغير سياسي أغلب الأحيان.
حكم العامة
قد يكون الأمل بالديمقراطية ضمن هذا السياق متعذّراً، ما لم يُعاد تعريفها بمعناها الأصلي القديم: حكم العامة، أي فرض سيادة وهيمنة الفئات التي لا تتمتع بالامتياز، وتحقيق مصالحها، على حساب سيطرة الفئات التي تندرج ضمن نظام امتياز مغلق أو شبه مغلق، مثل الأعيان والنبلاء والعسكر ورجال الدين.
غالباً ما أدى فهم الديمقراطية بهذا المعنى إلى تثويرها نحو مضمونها الأكثر راديكالية، أي سيادة الطبقات الأدنى، خاصةً أن العوام المتمتعين بالملكية، أي البورجوازيين الذين لا يحوزون امتياز النبالة، تراجعوا، في حالات تاريخية كثيرة، عن الأهداف الديمقراطية، وفضّلوا الدخول في تسويات مع الطبقات السائدة القديمة. قد يعني هذا في الحالة العربية ائتلافاً للفئات الأكثر تضرراً من الأزمات المعاصرة، التي لم تعد تملك شيئاً إلا حيويتها الحياتية، ولم يعد يمكن اختصار طموحها ومصالحها في حاكمية دينية هوياتية سابقة للسيادة الشعبية على طريقة الإسلاميين؛ أو وطنية تنويرية فات أوانها على طريقة «المدنيين».
في تونس يعمل الرئيس قيس سعيد على مواجهة المؤسسات المتأزمة للدولة التونسية بنمط من الشعبوية، التي تغازل آمال تلك الفئات، إلا أنه من الصعب التفاؤل بشعبوية محافظة ومفتقدة لـ«خريطة طريق» يمكنها انتزاع سيادة فعلية لمصلحة الفئات التي تدّعي تمثيلها.
كاتب سوري
القدس العربي
———————————
بعد أن قام الرئيس بإسقاط النظام : حدود الفعل وردة الفعل
اعداد : محمد العربي العياري – مركز الدراسات المتوسطية والدولية/تونس
ساحة سياسية تُحلّق في الفراغ: تباينات في ردود الأفعال
لازالت الساحة السياسية والمدنية في تونس، مُنشغلة بأحداث 25 جويلية 2021 وما ترتّب عنها من انقسامات حادّة اخترقت الجسم السياسي الديمقراطي في تونس. انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد للخطوات “التصحيحية” للرئيس، وبين رافض للإجراءات “الانقلابية”. وسط هذا “الستاتيكو” السياسي، ينهمك رئيس الدولة في جملة من الإقالات والتعيينات والخُطب البلاغية التي ترنو نحو تبرير ما أقدم عليه ليلة 25 جويلية. في حين لازالت الساحة السياسية تستقبل الموقف تلو الموقف، إلى درجة التناقض في بعض الأحيان، بين مؤيد ورافض، دون أن نلمس تحليلا واضحا مشفوعا برؤية لإدارة المرحلة القادمة، وينقل خط سير الأحداث من حالة الجمود واستفراد الرئيس بمراكز القوى، نحو مربع الفعل والضغط والتأثير في مجريات قادم الأحداث.
في إطار رصد ردود الأفعال، نقف على ثلاث مواقف تُحيّن بين يوم وآخر دون أن تخرج على سياق معناها العام:
الموقف الأول يتماهى كليا مع تحركات رئيس الدولة منذ 25 جويلية الجاري. حيث تعرض القوى السياسية وبعض الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين إضافة إلى حزب حركة الشعب والقيادات المؤسسة لحزب التيار الديمقراطي، مع بعض من النخب الفكرية والأكاديمية والإعلامية، ما نعتبره تبريرا ودعما لرئيس الدولة، مع رفع الحرج بالتنصيص على ضرورة ضمان الحريات العامة وتقديم خارطة طريق للمرحلة القادمة.
الموقف الثاني يتّخذ من الرفض المطلق لخطوات رئيس الجمهورية مُنطلقا للنقاش وتفكيك ألغاز الحقبة القادمة. تقف بعض القوى السياسية وشخصيات أكاديمية ووطنية مثل حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة وجزء من حزب قلب تونس في صدارة المقتنعين بشكل تحرك الرئيس ليلة 25 جويلية، حيث لا تخرج التحاليل التي يقدمها هؤلاء عن كون ما حصل هو انقلاب تام الأركان والشروط. يطرح أصحاب هذا الرأي، شروطا لإدارة المرحلة القادمة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، العودة الامشروطة لما قبل 25 جويلية بمعنى رفع اليد عن المؤسسات الشرعية المختلفة وترك المجال لمؤسسات الدولة للاشتغال وفق الشرعية الانتخابية، هذا قبل الحديث عن كل ملفات الإصلاح التي من الممكن إثارتها على طاولة النقاش.
الموقف الثالث الممكن التقاطه بعد مُضىّ الأسبوع ونيف من أحداث 25 جويلية 2021، يُعبّر عنه مزاج شعبي مُتقلّب ومنقسم بين مؤيد لرئيس الدولة وبين رافض لما حصُل. لا يمكن أن نتغاضى على رد الفعل الشعبي خاصة ونحن أمام منعرج تاريخي وفي مواجهة جماهير تمرّست على الممارسة الانتخابية والتداول على السلطة والنقد العلني للنخب السياسية، إضافة إلى حالة الارتباك والفوضى والغموض التي ميّزت عقدا من الانتقال الديمقراطي، مع تتالي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضافا إلى ذلك أزمة “الكوفيد”.
إن الإصغاء الجيّد لنبض الشارع وتبويب المواقف وفق عناوين الرفض والتأييد، يجعلنا ننضر بعين الريبة لمن هم ضد ومع في نفس الوقت. لا يمكن الاطمئنان للمؤيد وللرافض متى كانت الساحة السياسية ماضية في المحافظة على ركودها وصراعاتها الظاهرة حينا والمستترة أحيانا أخرى. لذلك، لا يمكن المجازفة بترك الرأي العام الشعبي في وارد الانتظار، وأن ننتظر منه دفاعا لا مشروطا ومتواصلا. هذا دون أن نتغاضى على خطورة انقسام الشارع بهذه الكيفية.
حدود الفعل ورد الفعل: بين إكراهات السياسة ومُقتضيات الديمقراطية
من الطبيعي أن يتداعى الفاعلون السياسيون وممثلي المجتمع المدني والنخب الأكاديمية، نحو التعاطي مع الأزمة بمختلف الآليات والطرائق. إلى حد الآن تتالت البيانات والعرائض بين المؤيد والرافض. ربما تكون هذه الوسائل “النضالية” من كلاسيكيات التعاطي السياسي مع الأحداث، لكنها في نهاية الأمر، واستنادا إلى موازين القوى، هي أقصى ما يمكن تقديمه في الظرف والزمن الحالي، دون حذف إمكانية التصعيد بتغير الأمور والاحداث. لكن قراءة هذه الردود تجعلنا نقف موقف المساند لبعضها والرافض لبعضها الآخر-دون أن نبخس حق الفاعلين على التصرف وفق ما يرونه صالحا- هذا مع الحرص على فحص نتائج هذه المواقف عمليا وليس من باب التنظير أو الترف الفكري الذي تتجاوزه المرحلة التي تمر بها البلاد.
المجموعة المؤيدة لرئيس الجمهورية، تعتبر أن الأحزاب السياسية التي تولت إدارة مرحلة ما بعد انتخابات 2019 مسؤولة عن الوضع الذي يصفونه بالمتعفن والرديء، لذلك وجب القيام بخطوة ما تُعيد الاعتبار للفعل السياسي برمته. يتناسى هؤلاء أنهم جزء من الوضع السياسي القائم باعتبارهم كأحزاب وشخصيات، وإن كانوا من خارج دائرة الحكم، فإنهم يتقاسمون جزءا من المسؤولية وإن كانت أخلاقية في أدنى حالاتها. هل كانت معارضتهم في حجم الرهانات المطروحة قبل 25 جويلية؟ ألم تكن ملفات الفساد المالي والسياسي معروضة على قارعة الطريق؟ هل توحدت قوى المعارضة لتشكيل جبهة صد ومعارضة تّجبر منظومة الحكم على تعديل مواقفها وتصويب بعض الإجراءات؟
قد يتعلل البعض بعبثية هذه الخطوات وعدم جدواها على الأرض، أو استحالة تطبيقها قياسا بالحجم الانتخابي والامتداد الشعبي لقوى الحكم أحزابا وشخصيات. نتجاوز نقاش هذا الطرح، لنتساءل عن الجدوى من التأييد “الأعمى” لرئيس الدولة. منذ صعود قيس سعيد إلى سدة الرئاسة وحتى قبل ذلك، ما انفك يُردد على مسامع الجميع موقفه من الأحزاب والنظام الانتخابي وشكل ممارسة الحكم. نحن إزاء رئيس يرفض التعامل مع أحزاب سياسية تتشكل وفق النظام القانوني القائم، وتمارس العمل السياسي استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2011، بل يرفض كل الأطر التنظيمية التي تشكلت بعد ثورة 2011. كيف يمكن تأييد من يؤمن بهذا الطرح واعتباره ضامنا لحياة سياسية خالية من شوائب ومعرقلات تُعطّل السير الطبيعي للدولة؟ التأييد يكون بصيغة الكل وليس الجزء، بمعنى أن نساند الرئيس كشخصية تحترم كل القوانين القائمة وشروط اللعبة السياسية برمتها، ليس أن نؤيد خطوة أقصت الخصم السياسي وننتظر الباقي حتى يأتي. ولكن متى يأتي؟ لن يأتي.
الجانب الآخر، يتعلق بنوعية الضغط الممكن ممارسته حتى نفرض نوعا من الحل السياسي الذي يُجبر الجميع بمن فيهم رئيس الدولة للقبول بالنقاش حول الحل. هذا الضغط لا يمكن أن يتجاوز تقديم مسودة للحوار مع بعض المسيرات الهادئة التي تقودها كبرى المنظمات الوطنية. هنا تكمن الخطورة، وربما القشة التي سوف تقسم ظهر البعير. حيث أن أي تحرك سوف يُفهم منه أن القوى التي دعت إليه تحولت إلى حاضنة لمن هم رافضون لإجراءات الرئيس، وبالتالي وقع خلق متنفس لهم لكسر الجمود وممارسة الفعل السياسي والتأثير عبر الشارع. وفي قراءة ثانية، إن ترافقت هذه التحركات بأعمال شغب سوف يقع اتهام الأطراف الرافضة “للانقلاب” بالتخريب والخروج عن القانون، وعدم قدرة الداعين للتحرك على تأطير تحركاتهم. بل ربما يُغلق ملف التحركات والمسيرات نهائيا تحت دعاوي الأمن القومي. لذلك لن تجازف هذه القوى بالتحرك في الشارع للضغط ولو برفع شعارات لا تتجاوز المطالب المتعلقة بالحريات.
أما عن الطيف السياسي والنقابي والمدني الرافض لما قام به رئيس الدولة، فلن تتجاوز ردود الفعل على المدى القريب شكل البيانات وتوسيع دائرة الرافضين والموقعين على بيانات الإدانة للانقلاب. نورد هذا، مع التذكير بأن حجم وشكل الاختلافات والتباينات التي تشق هذه “الكتلة” عميقة ومتعددة، فجزء من الذين ينتمون إلى أصحاب هذا الوقف، يصنفون “شركاءهم” في الموقف كممثلين للأحزاب السياسية والتيارات الفكرية والمدنية التي استأثرت بالحكم منذ 2011 ومسؤولة بشكل مباشر على حالة التخبط السياسي وكل النُدوب التي شوّهت الفعل السياسي في تونس. الجانب الآخر، يتمثل في حاجة هذه التيارات والشخصيات إلى حاضنة سياسية أو مدنية، وعلى الأكثر مدنية تُمثل الحامل للفكرة والحاضنة لأشكال رد الفعل. تاريخيا تلتقي كل مكونات الساحة السياسية في تونس داخل إطار الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره قاطرة تقود وتؤطر التحركات السياسية للطيف السياسي. في راهن الوضع، ومع البيان الصادر بتاريخ 3 أوت 2021 عن الاتحاد العام التونسي للشغل، يسقط هذا الطرح نهائيا-وإن كان ساقطا شكلا منذ بداية الأحداث- لكننا نورد هذا من منطلق الواجب السياسي وليس الممكن السياسي.
إذا، تبقى “جبهة” الرفض تحاول مراكمة الجهد والتنسيق دون أن يكون لذلك تأثير بمعنى “البراكسيس” من جانب قلب المعطيات وتحويل الصراع إلى وجهته السياسية بمعنى التأثير والانتصار في معركة وقع اختزالها في: شرعية/لاشرعية، انقلاب/إصلاح مسار.
غموض تلف ملامح الحل القادم: بين رئيس يزحف على الكل، وجزء سياسي ومدني ينتظر نهاية الزحف
إلى حد اليوم لم نلمس خطوات جوهرية تتعلق بتشكيل حكومة وتقديم خارطة طريق للمرحلة القادمة. هذا دون أن نتغافل على خطورة الخطوات التي أقدم عليها رئيس الدولة من اقالات وتعيينات تتعلق بالإدارة وبعض المسؤوليات الحساسة في الدولة مثل مدير المخابرات وبعض الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات الوطنية.
تأتي هذه الخطوات في إطار تفكير رئيس دولة لا يمارس السياسة، بل يُهيئ الأرضية لممارسة السياسة (وإن كانت هذه الخطوات في قلب السياسة)، عبر تنقية المحاور الحساسة في الدولة ووضع اليد على مرافق حيوية لا يمكن أن يتركها في متناول خصومه السياسيين أو يسمح لها بمواصلة اشتغالها بطرائق ما قبل 25 جويلية 2021.
يفكر رئيس الجمهورية في استنزاف قدرات المؤيدين أو المؤيدين باحتراز وذلك عبر توقيعهم لمذكرة “اعتزال” تقديم الحل بالشراكة معه، ومن ثمة، تفويض ذلك له شخصيا حتى يُمارس صلاحياته كرئيس للدولة مثلما يريد. في المقابل، تقف قوى التأييد على خط النار مُحترزين من فكرة تقديم الحل المتكامل والتحاور في تفاصيله مع رئيس الدولة وذلك تفاديا للتورط في الوقوع كشركاء مع سلطة ستتحول تدريجيا إلى تصفية كامل الجسم السياسي والمدني، تصفية بالقانون و”الشرعية الشعبية” كما يردد رئيس الدولة (جبهة الشعب). في نفس الإطار، ينتظر هذا الطيف المدني والسياسي مآلات وحدود تحركات الرئيس حتى تبلغ نهاياتها، ومن ثمة تتضح الرؤية حول ما يمكن طرحه ومناقشته.
طبعا لا يمكن الاطمئنان إلى هذه القراءات وتبويبها تحت خانة الفعل السياسي، هذا لأن السياسة لا تُمارس بمنطق الانتظار حتى تستقر الأحداث أو نلتقط نقطة ما من رحم الأحداث، لنحولها لمشروع سياسي أو ملف للمفاوضات.
إن لم يكن الفاعل السياسي خالق للحدث، مُتحكّما في مُجرياته، مُوجّها لدفّة الاحداث، فلا يمكننا الوثوق بقدراته على قلب معطيات الواقع أو حتى مجرد التأثير في إحداثياته لا تغييرها.
أمام هذا الجمود ومناورات المراهقة السياسية، تبقى مآلات الأمور بيد رئيس الدولة ولو إلى حين. مع رئيس أقحمنا بصورة واضحة في لعبة المحاور الإقليمية والدولية دون أن يكون المناخ السياسي جاهزا للعبة التوازنات الإقليمية، أو مستعدون كدولة للتمترس خلف دول لها مطامحها ومطامعها ولها من الإمكانيات والتقاطعات والتحالفات، ما يُمكّنها من الصمود أمام رياح السياسة العاتية التي تتواصل في أحيانا كثيرة في صور أخرى ومنها النزاعات المسلّحة.
في الختام، مع رئيس تحول في دقائق من رئيس جمهورية إلى رئيس دولة، عشية الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، وبعد أن قام بإسقاط النظام، نستقبل على بركة الفصل 80 من الدستور، عهدا من التطهير الفكري لكل ماله علاقة بالديمقراطية الحزبية والتداول على السلطة.
المركز الديمقراطي العربي
——————————
تونس من الإستثناء الديمقراطي إلى استثناء الديمقراطية أو عندما يُطيح الفصل 80 برأس الديمقراطية
اعداد : محمد العربي العياري/ مركز الدراسات المتوسطية والدولية/تونس
بتاريخ الخامس والعشرين من جويلية “يونيو” 2021 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد على جُملة من القرارات التي اختتمت يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، وأسدلت الستار على عقد من الانتقال الديمقراطي بمؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية. حيث أعلن على تجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، مع ترؤسه للسلطة التنفيذية وللنيابة العمومية، هذا بالإضافة إلى رفع الحصانة على كل نواب الشعب. ترافقت هذه القرارات مع تكليف الجيش الوطني بتنفيذها وحماية المنشآت الحساسة.
لم تمر هذه الأحداث دون أن تُثير جملة من ردود الأفعال ما بين المحلّي والدولي، حيث تتالت تصريحات قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بين مؤيد ورافض للإجراءات التي قذف بها رئيس الجمهورية في اتجاه ساحة سياسية تعيش منذ فترة أزمة حادة ألقت بضلالها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع جائحة فيروس الكورونا وما رافقها من انهيار شبه تام للمرفق الصحي، مما اجبر البلاد على الدخول في موجة من استجداء المساعدات والهبات الدولية لتدارك هذه الثغرة الخطيرة في “حرب” الدولة ضد الكوفيد. رافق ذلك تعبئة للشارع بين معارض ومؤيد “للشرعية” الانتخابية بتعبير أنصار النهضة المحتجين أمام البرلمان في الليلة الفاصلة بين 25 و26 جويلية.
مع انقسام الشارع التونسي وتداعي جزء من النخب الأكاديمية والسياسية نحو تبرير قرارات الرئيس، وجزء ينادي بضرورة العودة إلى ما قبل 25 جويلية، انتقلت الجمهورية التونسية من حالة الستاتيكو السياسي إلى وضع يُنبئ بصيف وربما خريف لن تنزل معدلات حرارته إلى مستوياتها العادية.
يُبرر رئيس الجمهورية دوافع ما أقدم عليه من إجراءات، بما يعتبره” تعفّن” الوضع السياسي وتجاوز دائرة المعقول والطبيعي في ظل وضع أصبحت معه الدولة على حافة الانهيار التام.
مع إشارات مقتضبة أراد من خلالها طمأنة الرأى العام والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، ثم لقاءات مع مختلف القوى الوطنية:( الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحة، الهيئة الوطنية للمحامين، نقابة الصحفيين التونسيين، المجلس الأعلى للقضاء، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، يظهر رئيس الجمهورية في صورة المُخطط الجيد والمستعد لمواجهة القوى الوطنية الفاعلة وإقناعهم بما يعتبره ضرورة وطنية رغم أنها “أبغض الحلال الديمقراطي”.
اختلفت تقييمات المنظمات الوطنية والشخصيات السياسية في قراءة ما حصل واستشراف تداعيات ذلك على كامل الجسم الديمقراطي في البلاد من أحزاب ومؤسسات. على ضوء هذه التقييمات، يمكن التوقف عند ثلاث قراءات توزعت بين ثلاث مجموعات:
ردة الفعل الأولى تمثلت في “مباركة” ودعم لقرارات رئيس الجمهورية وتبرير ذلك بمعطيات التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشت على وقعه البلاد طيلة عشر سنوات وضرورة تدارك الأمور بسرعة وحسم. يمثل المحامون وبعض من النخب الأكاديمية وحزب حركة الشعب وجزء من القيادات التاريخية لحزب التيار الديمقراطي ثم الاتحاد العام التونسي للشغل أصحاب هذا الموقف.
القراءة الثانية تلخّصت في رفض مطلق للإجراءات الرئاسية مع دعوة صريحة للعودة إلى ما قبل 25 جويلية. هذا الموقف يتباه حزب العمال والحزب الجمهوري، حركة النهضة وائتلاف الكرامة وجزء من الطيف السياسي كأفراد وبعض النخبة الأكاديمية.
القراءة الثالثة تمركزت بين قبول للواقع الجديد مع دعوة رئيس الجمهورية إلى تقديم خارطة طريق تُوضّح سيرورة الأحداث ومآلات الأمور في قادم الايام. يصدح بهذا الموقف بعض من الإعلاميين وأساسا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
بهذه المواقف، يبقى البيت الداخلي متذبذبا بين قراءات تتقاطع أحيانا وتتنافر في أحيان أخرى، يدفعها في ذلك طغيان منطق الحسابات السياسية لعائدات التموقع أوالمصلحة الوطنية أو كلاهما معا. لكن الثابت إلى حد اليوم، أن أيّا من هذه الأطراف لم يتلقى ردودا واضحة-عدى بعض التطمينات- من رئيس الجمهورية، حيث ينتظر الشارع التونسي ومن خلفه هذه المنظمات والأحزاب والشخصيات، ما يمكن أن تؤول إليه الأمور على ضوء قرارات رئيس الدولة والتي تواترت بصفة تكاد تكون يومية وأحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد على امتداد 5 أيام منذ يوم 25 جويلية.
لا يمكن أن يمر حدث كهذا دون أن تلاحقه موجة من ردود الأفعال الدولية التي تتخذ شكل المواقف الديبلوماسية الرسمية في مرحلة أولى، على أن تتطور بحسب تصاعد المواقف في الداخل وما يمكن أن تؤول إليه أمور السياسة والعلاقة بين الفاعلين السياسيين. في هذا الإطار، تابعنا تصريحات مختلف المسؤولين عن السياسة الخارجية لبعض الدول، والتي نستطيع تبويبها في أربع مواقف.
الموقف الأول كان تعبيرا على دعوة “لطيفة وناعمة” من فرنسا وألمانيا للرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بالعودة إلى وضع المؤسسات الدستورية مع احترام الشأن الداخلي التونسي وعدم التدخل في مجريات الأحداث باعتبارها شأنا يهم التونسيين فقط. فرنسا التي كانت حاضرة بقوة منذ انطلاق موجة الربيع العربي من تونس إلى ليبيا وسوريا، مع ملف ثقيل بانتهاكات عسكرية داخل التراب الليبي واستضافتها لجزء من المعارضة السورية، مع داخل يسير نحو التأزم بفعل الكوفيد واحتجاجات شعبية بين الحين والآخر، تبحث عشية انتخابات رئاسية على تعزيز تواجدها الاقتصادي والسياسي في تونس، والمحافظة على بوابة عبور آمنة نحو العمق الإفريقي، تُغذّيه رغبة في تحويل الرهان السياسي من سلطة منتخبة ومتواجدة منذ 2011 إلى حليف جديد يُتقن الحديث باللغة الفرنسية وأشياء أخرى. أما ألمانيا التي تبحث على الاستفادة من أزمات الربيع العربي، والتي أجادت توظيف مسألة اللاجئين السوريين، ثم عودتها إلى قيادة القاطرة الاقتصادية لأروبا بأكملها- أوروبا دون إنجلترا- لا تنظر إلى من يحكم بقدر ما يهمها كيف سيحكم. لذلك هي تحاول الاستثمار في رئيس جديد تمكّن من حشد جزء هام من الشعب عشية إعلانه على إجراءاته الاستثنائية. ينضاف إلى أصحاب هذا الرأي، الولايات المتحدة الأمريكية التي تُلقي إدارتها بمواقفها الرسمية عبر صفحات جريدة “النيويورك تايمز”، في حين ينتهج ممثلي الديبلوماسية الرسمية سياسة “نحن نؤيدك إلى حد ما”. يبقى هذا الحد مفتوحا على التوسع في الزمن تحت تأثير عقارب الساعة التي سوف يقع تعديلها حسب توافقات وعناوين سياسية من المنتج (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى المستهلك (النظام السياسي التونسي).
بالمحصلة، هي مواقف خجولة في زمن الاستثناء الديمقراطي.
الموقف الثاني تُمثّله دول مثل السعودية ومصر والإمارات والتي كانت ولازالت تدفع باتجاه إقصاء حركة النهضة وجزء من الفاعلين السياسيين من المشهد السياسي، مع الاستعداد للمراهنة حتى على حصان أعرج في سباق قيمة جائزته أعظم ارتفاعا من برج خليفة في دبى.
الموقف الثالث يتكون من دول الإقليم (ليبيا والجزائر) التي تتأثر ضرورة بما يحدث في تونس. ليبيا التي تتلمّس طريقها نحو الاستقرار السياسي مع سلطة وليدة مخاض عسير من المفاوضات بين تيارات سياسية أنهكها الإحتراب الداخلي والتقاتل على امتداد عقد من الزمن، ولم يعد من الممكن التعايش في تماس مع إقليم جغرافي يُمثل متنفّسا وشريان حيوي فقد بين عشية وضحاها تراكمات زمن ديمقراطي يبقى مثالا على قدرة الشعوب العربية على تلمّس الديمقراطية فكرا وممارسة. أما عن الموقف الجزائري، فقد حافظ على نغمة متوسطة تُترجم بفائض من الاحتراز عن التصريح العلني بما يُخامر العقل السياسي الجزائري. لكننا نستطيع فك شيفرة التحفظ والصمت عن الإدلاء بموقف على الملأ، حيث لا تطمح الدولة الجزائرية إلا لحفظ الأمن على حدودها الشرقية وقطع الطريق عن كل تسرُّب ممكن لفتيل احتراب أو أزمات سياسية قد تتخذ أشكالا أخرى. بالمحصلة، لن تحيد الجزائر على مطلب الحفاظ على استمرارية الدولة التونسية، والمحافظة على الحد الأدنى الديمقراطي المكتسب وفق مطالب وخصوصيات وشروط التونسيين دون سواهم.
الموقف الرابع يُحسب على تركيا وقطر. تركيا التي تعاملت مع انقلاب انتهى بتعزيز سلطة حزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية، والتي تبحث –عبر قنوات متعددة- منها السياسي والاقتصادي والعسكري، على تمديد نفوذها من آسيا إلى إفريقيا بشراكة استراتيجية مع دولة روسيا الفيدرالية (مشروع السيل التركي)، وتحالف موضوعي مع شق من الفاعلين السياسيين في ليبيا، لم تتوانى عن دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد للعودة إلى الشرعية التي أفرزتها صناديق الانتخابات. أما قطر، العائدة إلى أحضان مجلس التعاون الخليجي مع تفاهمات بغلق بعض الملفات منها تمويل ودعم الأحزاب ذات الميول الإسلامية –ومنها حركة النهضة التونسية- لم يتجاوز موقفها دعوة رئيس الجمهورية إلى مواصلة الاضطلاع بأدواره الطبيعية كضامن للحقوق ومكتسبات الانتقال الديمقراطي، دون إدانة أو ممارسة نوع من الضغط.
هذه جملة من القراءات لردود الأفعال لبعض الدول التي تفاعلت مع ما وقع في تونس من أحداث. بالعودة إلى قيس سعيد، وسجلّه التأويلي لنصوص الدستور، فإن سلسلة الإرهاصات أو مؤشرات ما تجرأ عليه من إغلاق لصفحة الانتقال الديمقراطي، تُحيلنا جميعها إلى التذكير بما كان يُردده هذا “الفقيه” الدستوري من تأويلات استأثر بها لوحده بعد اعتلاءه سدّة الرئاسة، إضافة إلى سخطه المتواصل على الأحزاب والنظام السياسي والانتخابي. تواصل هذا الطرح “الشوفيني” متناسيا أن الدستور والنظام الانتخابي وقيادات وقواعد الأحزاب، هي من صعّدته إلى منصب رئاسة الجمهورية.
بتتالي “التهريج” الذي حصل في أروقة البرلمان من قبل طرف ينتمي إلى نظام ما قبل 2011، مع أزمات سياسية ومالية متتالية، يلتجئ رئيس الجمهورية إلى استثناء الديمقراطية، دون علم منه بأن حالة الاستثناء التي تحدث عنها يوم الإعلان عن قراراته، لا يمكن أن تطرح في سياق كلام يُلقى على عواهله دون إلمام بشروط وآليات وكيفيات الاستناد إلى حالة الاستثناء. الإيوستيتيوم Iustitium أو تعليق القانون كما فسّره جورجيو أغامبن وكارل شميت، بعيد كل البعد عن تأويلات رئيس تحوّل من رئيس للجمهورية بما تعنيه من مؤسسات وسلط مستقلة، إلى رئيس للدولة بما تعنيه من عقل واحد ورأى أوحد.
أن يطلق قدماء العسكريين دعوات إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، ومن قبله رفض رئيس الدولة لمبادرات الحوار الوطني في جولات مفاوضات متعددة، وأن يتحدث على انقضاء المدة الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، ثم زيارات متتالية لدول مثل فرنسا ومصر وما رافقها من سيل من النقد، كلها كانت ولازالت دليلا على عدم قبول رئيس الدولة للتفاعل مع مُخرجات الانتقال الديمقراطي.
تبحث بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، على مخرج للمأزق الحالي من خلال النقاش حول مبادرة قد تتخذ شكل خارطة طريق أو برنامج لتسيير الدولة في فترة لابد أن يقع تحديدها في أقرب الآجال. في المقابل، يقف رئيس الجمهورية مستندا على دعم حصّله من جزء من الشعب ومن النخبة السياسية والأكاديمية، منتظرا أقصى ما يمكن أن تطرحه القوى الوطنية، وتنازلات خصمه السياسي (حركة النهضة)، وأعداءه الطبقيين المُفترضين (الفاسدون) مثلما تعود ترديده في كل مناسبة.
مع رئيس طالما رافقته تهمة الشعبوية وتكرار خطاب ممجوج بفائض من لغة لاتُسمن من فقر سياسي ولا تُغني من جوع في الرؤى والبرامج، ويُهيّئ الأرضية لممارسة السياسة مثلما يريدها، ننتظر مآلات الأمور في قادم الأيام حتى نكتشف جينات وطبيعة ديكتاتورية ناشئة استثنت الديمقراطية، في زمن كانت فيه الجمهورية التونسية بلد الاستثناء الديمقراطي.
المركز الديمقراطي العربي
——————————–
تونس أمام رهان التأسيس والمراجعات: أحزاب وبيروقراطية إدارية وبورجوازية ريعية/ لطفي العبيدي
التعريف الواضح للمصلحة الوطنية، لا بدّ أن يكون بالمثل مرشدا إلى السياسة القائمة على المبادئ والقيم، والمتفاعلة مع وجدان الشعب، الذي يستحق حياة كريمة. والفضائل الممكنة أو المتخيّلة لا تسوّق نظريّا، بل تُترجم عمليّا بالنظافة والترميم، والتوجّه لخدمة المصلحة الوطنية والإخلاص للأمانة. والفوضى السياسية وغياب الرؤية يغذي الانهيارات غير المسبوقة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ما بالك بمواصلة الدولة تخلّيها عن دورها المركزي في التخطيط الاستراتيجي في المجال التنموي، ومراعاة التوازن الطبقي والجهوي، بلد يصل إلى هذه المرحلة يستحق الإنقاذ قبل أن يفوت الأوان.
منذ ثورة يناير 2011 ساد منطق الحكم الذي يقوم على المحاصصة والتمكين. وانتهى التفكير الغنائمي، والرغبة في السيطرة على مؤسسات الدولة، إلى خلق هوّة سحيقة بين شرائح الشعب الواسعة ومكوّنات المجتمع السياسي، الذي لم يتفاعل بجدية مع الشأن العام واستحقاقات الثورة، فعندما لا تجدّد المؤسسات السياسية والاجتماعية نفسها على قاعدة النقد الذاتي والمراجعات، فإنّها تفرز جهازا بيروقراطيا فاسدا، يتحول شيئا فشيئا إلى بورجوازية ريعية تنهب مؤسسات الدولة، ويصبح الشعب بمثابة خصم أمامها.
وهذا ما حدث في تونس، واستماتت بعض المكونات السياسية في المحافظة عليه، وكأنّ الحكم بالنسبة لهم يعني على الدوام السيطرة على الدولة من أجل أغراض حزبية فئوية، وترسيخ ثقافة الابتزاز، وتمتين رابطة المصالح مع رجال الأعمال ولوبيات الفساد. ورغم هذه البراغماتية المكشوفة التي تستفيد منها البيروقراطية الإدارية، مازالت بعض الأحزاب الحاكمة تجاهر بالعدالة الاجتماعية، وتدّعي الديمقراطية، وتعتقد أنّها تتستّر عن توجّهها المنفعي ومطالبها الفئوية، التي أوغلت فيها على نحو أضر بالدولة والمجتمع. وهم يتغافلون عن إدراك أنّ هذا التمشي هو ما أوصل إلى مرحلة الانفجار الثوري التونسي، الذي تداعت له بقية الشعوب العربية. وبعض الأصوات استفاقت الآن على وقع ما حدث من قرارات استثنائية أعلنها رئيس الجمهورية، وأصبحت تطالب قياداتها بالتنحي عن رئاسة الأحزاب، وتنتقد سلوكها السابق في الإطاحة بالحكومات، بغرض التحالف مع أطراف بعينها متهمة بالفساد، واتضح لهم بأنّ قياداتهم التنفيذية كانت مخطئة، وخطواتها لم يكن فيها مصلحة للبلاد، ولا حتى لهذه الأحزاب نفسها. مذكّرين بأن قيس سعيد لم يأت من الثورة المضادة، وبأنه كان من المفروض أن تستبشر به النهضة وغيرها، وتجد معه الحلول.
الانتقال الدّيمقراطي الحقيقيّ يقتضي تغيير سياسات الحكم، التي تسبّبت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن منوال تنمويّ مغاير خارج رابطات المصالح، وغير خاضع للأجندات الخارجيّة. يكون في خدمة المصلحة الوطنية، ويتفاعل مع تطلعات الشعب وأمانيه دون غيرها. ومع الأسف، هناك من ورث منطق النهب وسلوك الغنيمة، وافتكاك مؤسسات المجتمع وخيراته، وباستخدام يافطة الإصلاح الكاذب وإعادة الهيكلة، قاموا بالسطو على قطاعات مركزية، كالتعليم والصحة والثروات الإنتاجية، إلى جانب القطاعات الأخرى، ويتمّ ذلك تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية الفاشلة، التي أفرزت رأسمالية طفيلية لا تدفع الضرائب، فغدت عالة على الدولة، وعمّقت معاناة الطبقة الوسطى والفقيرة، ووجدت تعبيراتها في رجال أعمال فاسدين ومفسدين، أعادوا تمركزهم بفعل مشاريع المصالحة المشبوهة، ومتّنوا تحالفاتهم المنفعية مع الأحزاب الحاكمة، على قاعدة الصفقات والمصالح المتبادلة، وتمّ كل ذلك بشكل مماثل لما فعله الكارتيل الحاكم سابقا، على نحو من الاستمرارية والتعنّت، ووراثة خيبات حزب التجمع المنحلّ، وممارساته التي دمّرت المجتمع والدولة.
تبقى عملية إصلاح النظام من الداخل، وتسهيله لعملية التحوّل الديمقراطي، وإرساء مؤسّسات دولة مستقرّة وفاعلة، ومحاربة الفساد هيكليّا، أسلوبا في الانتقال نحو الديمقراطية. وليس على نحو تطويع الثورة وتعويم المفاهيم وجعل الانتقال شكليّا لا يتجاوز الظّاهر، ولا بأس في أن يتمّ وصفه بأنّه ديمقراطيّ. وتلك أزمة مفاهيم حقيقيّة يتمّ من خلالها احتراف المناورات والتّلاعب بآمال شعب طمح في الكرامة، وفي وطن محفوظ السيادة، فجميع الأحزاب لا تمتلك رؤية لمحاربة الفساد، ولم تطرح مشروعا متكاملا في هذا الشأن، بل إنّ أغلبها اكتفى بالتشكيك والقدح واستدامة العراك الأيديولوجي عنوانا للتعطيل والتقصير الفادح، الذي يتحمّل مسؤوليته جميع الفاعلين السياسيين. وحركة النهضة التي اعتبرت قيادتها أنّها مستهدفة من الإجراءات الجديدة، وكأن وجودها في الحكم ثورة، وخروجها منه انقلاب، تعيش تناقضات داخلية وخلافات بيّنة، عبّرت عنها شخصيات مؤثرة داخلها، يبدو أنّها تحاول هذه الأيام إنقاذ الحركة من ممارسات أحادية وخيارات خاطئة، فُرضت من قبل قيادتها التي كان همّها الوحيد أن تؤبّد سيطرتها على مواقع القرار، فكلّ الخطوات التي أقدمت عليها بما فيها قانون المصالحة، وتجربة التوافق مع المنظومة السابقة، ودخول عدد كبير من التجمّعيين إلى الحزب لغرض التحصنّ والحماية، وآخرها التقارب مع حزب ارتبطت به قضايا فساد وتبييض أموال، وأقدم رئيسه على التعامل مع أطراف صهيونية لتلميع صورته والفوز في الانتخابات، قد تمّت بمعزل عن القواعد، خاصة الشبابية منها، وإن أظهرت نوعا من التّواصل الشّكلي البروتوكولي الذي لا يغيّر شيئا، ولا يعبر عن ديمقراطية داخل الحزب الذي يحتكر قيادته شخص لما يقارب 40 عاما. وهي واقعية محرجة، ومخلّة بالنسق التعدّدي إن كان قابلا لاستيعاب أشكال الاختلاف السياسي، بالنظر إلى مستقبل مثل هذه الأحزاب القائمة على شخصانية مطلقة، وعلى دوائر مصغّرة تحتكر الفعل والقرار. ومثل هذه السلوكيات التي حوّلت الأحزاب التقليدية إلى جهاز بيروقراطي متكلّس، تعكس في مجملها مشهدا سياسيا تحكمه المفارقات المفضوحة، كل الدكاكين الحزبية فيه مفلسة، تمتلك خطابا مناورا، وتشتغل على الواقعية كتبرير للمواقف الانتهازية. والجميع يحمل في داخله مسعى المناورة، فينتصر للذاتي بعيدا عن الموضوعي، وهو أمر يكشف البون الشاسع بين تغليب السلطة كغاية، ومسعى تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي نحو الأفضل.
الشعوب لا يمكن أن تظلّ رهينة بيد المضاربين السياسيين وأصحاب الصفقات في سوق الكساد السياسي وتضارب المصالح. وإذا كان هدف مثل هذه الأحزاب التقليدية المشاركة في عملية الإصلاح الوطني بعيدا عن منطق اقتسام الغنيمة، فمن واجبها التقليل من الغرور والأحادية حتى لا تغرق سفينتها، والواجب الوطني يقتضي التفاعل الإيجابي مع مطالب الشعب، والقطع نهائيا مع المنظومة التي ثار ضدّها التونسيون، وليس إقامة تحالفات معها أو مع من هم أسوأ منها. وما يجب أن يستوعبه الجميع هو أنّ رفض مطالب التغيير والمواطنة الاجتماعية العادلة على مدى عقود طويلة، ومن ثم تعطيل هذا الاستحقاق بعد الثورة، يؤكد أن المهمات الحقيقية لبناء المجتمع المنشود لم تنجز بعد. وهي الهموم الكبرى، لا بالنسبة إلى عملية بناء المجتمع الجديد فحسب، بل بالنسبة إلى استقرار الدولة الجديدة أيضا. واليوم هناك فرصة تاريخية لإعادة البناء والتأسيس، ولا مجال للتردّد أمام محكّ الإصلاح والمراجعات.
كاتب تونسي
القدس العربي
———————————
تونس بين مطرقة التدخل الخارجي وسندان الانهيار الداخلي/ عبد الحميد صيام
لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس هذه الأيام، مع العلم أنها ليست وليدة شهر أو سنة أو سنتين، بل بدأت بوادرها تظهر بعد انتصار شباب ثورة الياسمين، والإطاحة بحكم الاستبداد والفساد الذي مثله زين العابدين وعائلته لمدة 23 سنة. وللأزمة الحالية عدة وجوه والخطأ أن ننظر إليها، أو نحاول تحليلها من منظور واحد، كإطلاق حكم مطلق بأنها انقلاب، أو أنها تجديد لثورة الياسمين، أو أنها استكمال لجهود إجهاض ثورات الربيع العربي، أو أن الأزمة سببها حزب النهضة فقط، فالأزمة حقيقة توليفة معقدة من كل هذه الأسباب مجتمعة ويمكن أن نضيف عليها الكثير.
وسأحاول كغيري أن أطرح تصورا لما يجري، وأعرف أنني كمن يسير في حقل ألغام قد ينفجر أحدها في أي لحظة. فمن السهل أن نقول إن ما حدث انقلاب أو ثورة جديدة وانتهي الأمر وسيأتي من يصفق لك وآخر يخونك ويتهمك بالعمالة. لكنني سأحاول أن أطرح بعض الملاحظات بقدر كبير من الموضوعية، كشاهد عيان زار تونس خمس زيارات بعد الثورة، ومتابع عن قرب للشأن التونسي.
الأوضاع الموضوعية في تونس عشية الثورة
تونس بلد صغير مساحة وسكانا.. ولأن تونس بلد مسالم لا عداوة له مع أحد فقد خصص جزءا أساسيا من موارده للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتنمية، خاصة في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، الذي يذكره التونسيون بخير ويترحمون عليه، بعدما شاهدوا ما حدث بعد رحيله من كبت للحريات وفساد وتكريس لحكم الإستبداد.
تميزت تونس بثلاث مزايا لا تكاد دولة عربية تصل إلى مستواها في هذه الخصال وهي: إبعاد الجيش الصغير نسبيا عن السياسة، منذ بداية الجمهورية الأولى عام 1956، وقوة المجتمع المدني ووعيه وتأثيره، خاصة الاتحاد العام للشغل الذي عجزت فرنسا وبورقيبة وبن على وحكومات ما بعد الثورة عن احتوائه. وقد استحقت منظمات المجتمع التونسي جائزة نوبل للسلام عام 2015 عن جدارة واستحقاق. والميزة الثالثة والمهمة غياب العنف والاغتيالات في الحياة السياسية للشعب التونسي. ولم يتم تسجيل أي حادثة عنف أو اغتيال حتى قيام الثورة، إلا مرة واحدة عندما اغتيل معارض بورقيبة الكبير، صالح بن يوسف، في فرانكفورت بألمانيا عام 1961، أضف إلى ذلك تجانس الشعب التونسي وغياب العشائرية والقبلية البغيضة، وارتفاع نسبة التعليم واتساع رزمة حقوق المرأة وتمكينها. بورقيبة ترك بلدا فقيرا يعتمد أساسا على الزراعة، وتصدير زيت الزيتون والحمضيات. وكانت السياحة تأخذ حيزا من الاقتصاد، لكنها لم تكن الأساس، لكن بن علي حول البلاد إلى فندق كبير، وكانت جل الاستثمارات الأجنبية في ميدان السياحة فأصبحت البلاد رهن شركات السياحة، التي لا تعمل إلا ضمن الاستقرار والهدوء والحريات العامة. وعندما وقعت أول عملية إرهابية في تونس بتاريخ 11 إبريل 2002 واستهدفت معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة، التي تبنتها «القاعدة» انهارت السياحة تماما لعدة سنوات. بعد انطلاق ثورة الياسمين وهروب بن علي من البلاد توقفت السياحة تقريبا عن معظم الدول العربية التي شملتها الانتفاضات. الفرق أن تونس كانت تعتمد أساسا على السياحة، فكيف لها أن تواجه الوضع الجديد الذي شهد انهيارا للعديد من المؤسسات؟ كما شهدت البلاد هروب كبار رجال المال، وتهريب المليارات خارج الوطن. ثم سرعان ما تحول جماعة بن علي الذين كانوا يعملون لصالحه إلى العمل لحساباتهم الخاصة. ومع مرور السنوات بعد الثورة بدأ تردي الأوضاع الاقتصادية يتفاقم، فانتشرت الإضرابات، وارتفعت الأسعار بشكل خيالي، وانخفضت قيمة الدينار ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 18%،. وما كان يمر يوم بدون أن تكون هناك مظاهرات احتجاجية أو اعتصامات أو إضرابات، وما فاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد الحرب الأهلية في الجارة ليبيا، الشريك الأكبر والأهم لتونس. فقد كان يعمل في ليبيا عشرات الألوف من التوانسة الذين يدرون دخلا ضخما بالعملة الصعبة للبلاد. وقد قدر عدد التوانسة المقيمين والعاملين في ليبيا لغاية 2012 أكثر من 83000 مواطن. كذلك كانت تونس هي الجهة المفضلة لآلاف الليبيين للسياحة والتجارة والاستثمارات، التي توقفت بشكل أو بآخر. ومع كل هذه الصعوبات الاقتصادية ظلت العاصمة تونس تشهد بناء الأبراج الضخمة والمباني الفاخرة والأسواق التجارية.
وتجد المقاهي الحديثة في منطقة البحيرة، تتنافس في الجمال والديكور والخدمات. فمن أين كل هذه الأموال؟ لقد تحولت تونس إلى مركز كبير لتبييض الأموال، وانتشرت الجماعات الناهبة والسارقة تحت حماية من الأقوياء.
تدخلات خارجية – أخطاء وخطايا
من كان يعتقد أن قوى الثورة المضادة ستترك تونس في حالها فهو مخطئ، بل العكس، فكلما تمسك التونسيون بديمقراطيتهم وتجاوزوا العقبات، زادت التدخلات وزاد التصميم على إسقاط التجربة الوحيدة التي استطاعت أن تتجنب مقصلة محور الثورات المضادة، التي كانت وظلت مصممة على إقفال باب التحول الديمقراطي. وقد قادت معسكر الثورات المضادة دولة الإمارات، بدعم من السعودية والكيان الصهيوني ثم مصر لاحقا، لقد تم استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة أبشع استغلال، كما تمت الاستفادة من مناخ الحريات، خاصة حرية التعبير، فانطلقت عشرات القنوات الفضائية التي تحرض الشعب التونسي على حركة النهضة، متهمة إياها بالشرور كافة. لقد مثلت ظاهرة عبير موسي الوجه الأكثر وضوحا في هذا المجال، لقد مولت الإمارات كل الحركات المعادية للديمقراطية، وسرّبت وثائق عديدة في هذا المجال كان أهمها « الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس» المنسوبة إلى مركز الإمارات للسياسات، لترتيب انقلاب عن طريق وزير الداخلية المقال، لطفي براهم، بعد أن خذل الرئيس الباجي قايد السبسي الإمارات، التي دعمت حزبه «نداء تونس» لكنه عاد وتحالف مع النهضة. لقد حاولت الإمارات وما زالت إسقاط التجربة التونسية عن طريق المال والإعلام، واستغلال العمليات الإرهابية والفوضى لوأد الثورة التونسية، لتنضم إلى الثورات الموؤدة في ليبيا واليمن ومصر وسوريا والبحرين. وقد تصاعدت تللك الوتيرة بعد فشل مراهنتها على الجنرال خليفة حفتر في ليبيا.
هذا لا يعني أن حركة النهضة لم ترتكب أخطاء قاتلة، حرّضت الشارع التونسي ضدها، خاصة تسترهم على الفساد والفاسدين، وتحالفهم مع جماعة بن علي. لقد تحولت النهضة 180 درجة عندما عادت وتحالفت مع نبيل القروي وحزبه «قلب تونس» الذي خاض الانتخابات الرئاسية الأولى وهو في السجن بتهمة الفساد، ثم أعادت النهضة تأهيله وسمته سجين الرأي. كما أنها تحالفت مع بقايا نظام بن علي ورموزه المعروفين. وفي ظل هيمنة النهضة على الحياة السياسة، خاصة في السنوات الأربع الأولى، انتشر التطرف والعمليات الإرهابية ضد الجيش، واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واستهدفت المرافق السياحية بالعمليات الإرهابية، مثل المتحف وشواطئ سوسة. ومع أن النهضة لم تتهم مباشرة بهذه الأعمال، إلا أن الشعب التونسي واثق من أن المناخ المتطرف الذي انتشر بعد الثورة في ظل النهضة هو المسؤول. نقطة أخرى سمعتها من كثير من التوانسة وهي أن شخصية راشد الغنوشي ليست شخصية جامعة موحدة بعكس عبد الفتاح مورو، الذي يحظى باحترام الشعب التونسي بشكل عام، حتى الذين يختلفون معه. لقد لعب الغنوشي دورا في إبعاده عن المسرح السياسي، حيث رشحه للرئاسة وجاء ترتيبه الثالث بين المرشحين وحمّله الغنوشي مسؤولية الفشل، ليخلو له منصب رئيس البرلمان، وهو ما حدث فعلا وفاقم الأمور أكثر وأدى إلى شبه شلل في الحياة التشريعية التي يمثلها البرلمان.
قرارات الرئيس يوم 25 يوليو
لقد جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد على هذه الخلفية، التي وصلت إليها البلاد خاصة في ظل انهيار الوضع الصحي، بسبب خروج جائحة كورونا عن السيطرة. إذن تجمعت كل هذه العوامل لتساهم في تقبل الشارع التونسي الخطوات الخطيرة التي اتخذها الرئيس، والتي لا شك تعتبر انتهاكا للدستور لا يحتاج المتابع كثيرا من الجهد ليثبت هذا الانتهاك. لكن الشعب التونسي بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب العديدة بما فيها النهضة، ستعطي الرئيس الفرصة التي طلبها وهي شهر كامل للقيام بإصلاحات جذرية، لكن ليس على حساب الديمقراطية، بل لتثبيتها وتخليصها من الشوائب ومافيات الفساد. أما إذا أصر على التمسك بالسلطات جميعا ليتحول الحكم إلى سلطة الفرد المستبد، فليس أمام الشعب التونسي الواعي إلا فرض إعادة الديمقراطية… فالاستبداد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانهيار والاحتراب الداخلي وتدمير إمكانيات النهوض والازدهار.
نريد للتجربة الرائدة في تونس أن تبقى رائدة لدحض نظرية المؤامرة، التي روج لها النظام العربي بشقيه الفاشي والرجعي، كي يفقد الأجيال العربية الصاعدة ثقتها بنفسها وكي يثبت من جهة أخرى أن الديمقراطية نبتة غريبة لا مكان لها في بلاد العرب التي لا ينفع معها إلا النظام الجمهوملكي المسلح بأجهزة الموت. الشيء المشترك الذي يتفق عليه أبناء تونس جميعا أن حل المشاكل لا يتم إلا بالحوار والحوار فقط وعدم اللجوء إلى أي أسلوب آخر، لأن قدر تونس أن تنجح وقدر ثورتها أن «تعيش رغم الداء والأعداء ـ كالنسر فوق القمة الشماء» كما حدثنا أبو القاسم الشابي قبل نحو قرن من الزمان.
محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي
القدس العربي
————————-
تونس: خلافات عميقة تفضّ اجتماع شورى “النهضة”/ آدم يوسف و بسمة بركات
شهد الاجتماع الاستثنائي لمجلس شورى حركة النهضة، المنعقد ليلة أمس الأربعاء، خلافات عميقة داخله منذ بداية أعماله بدعوة زعيم النهضة راشد الغنوشي إلى “تحويل إجراءات 25 يوليو إلى فرصة للإصلاح وأن تكون مرحلة من مراحل المسار الديمقراطي”، ليحتد الجدال بين دعاة تصحيح المسار الداخلي، ومناصري الصمود والتصعيد، وينتهي فجراً بانسحابات عديدة من اجتماع المجلس قبل إعلان بيانه الختامي.
وطغى الشأن الداخلي للحركة على المسألة الوطنية، رغم تداخل الملفين وتلازمهما، بين دعاة تركيز الاهتمام على تحركات الحزب ما بعد 25 يوليو وتنظيم الصفوف لبحث سبل التصدي لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد وحشد الدعم في جبهة لمقاومتها واستعادة البرلمان، وبين من يعتبرون أن الشأن الداخلي وأزمة التسيير وأخطاء القيادة جزء من الأزمة وأحد مسببات الانفجار الاجتماعي والأزمة الاقتصادية والسياسية.
وبدا موقف الغنوشي في بداية الأعمال منسجماً مع المطالبين بالإصلاح وتصحيح المسار داخل الحزب وعلى مستوى القيادة، واعتبره مراقبون مسايرة للوضع وربما مناورة لإنقاذ الحركة داخلياً بحماية وحدتها وبفتح نافذة تفاهم مع الرئيس بدل الدخول في مواجهات جديدة وتصعيد الخلاف، غير أنّ رأياً آخر دفع إلى التمسك بموقف المكتب التنفيذي القائم على ضرورة مقارعة الانقلاب وحشد الجهود لمناهضته سلمياً.
وسارعت قيادات لدحض دعوات تصحيح المسار الداخلي لإعلان موقف لا يختلف عن موقف المكتب التنفيذي، فيما بدت منذ الساعات الأولى حالات الارتباك والتشتت من تدوينات عدد من القيادات البارزة.
وسارع عضوا الشورى، رفيق عبد السلام وأسامة بن سالم، إلى تكذيب ما جاء على لسان سامي الطريقي الذي نقل عن الغنوشي رواية الاستفادة من الفرصة للإصلاح، مؤكدين أنها لا تعبّر عن اجتماع الشورى، وهي قراءة شخصية.
واختار عدد من القيادات من المطالبين بمراجعات، الانسحاب دون استكمال الأعمال، بسبب تعنّت مواقف مجموعة الصمود وتمسكها بالرأي، إذ نشرت القيادية جميلة كسيكسي على حسابها في “فيسبوك”، قائلة: “أعلن انسحابي من دورة الشورى وأي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمني. كل الخير لتونس كل الحب لشعبنا ويبقى الأمل”. ولا يبتعد موقف القيادية يمينة الزغلامي عن ذلك، إذ قالت بدورها في تدوينة: “أعلن الآن انسحابي من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمرّ بها الحركة والبلاد. لن أكون شاهدة زور ربي يحفظ تونس”. وفي السياق نفسه، دونت القيادية منية إبراهيم على حسابها الشخصي في “فيسبوك”، قرار انسحابها وعدم تحملها مسؤولية القرار الذي سيصدر عن الشورى ورفض أن تكون “شاهدة زور”.
وقالت كسيكسي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن القرارات التي اتخذها مجلس الشورى “لا تلزمها”، مبينة أنهم “كانوا ينتظرون المبادرة بالاعتراف بالتقصير الذي حصل، وتحمّل المسؤولية”، مستدركة: “صحيح أنها مسؤولية مشتركة وتضم عديد الأطراف ولا تشمل النهضة فقط، لكن الشعب عندما غضب على النهضة لأنه كان يراها حزباً كبيراً.
وأوضحت أن “النهضة لم تكن مضطرة لكي تكون دائماً في الحكم، وكان بالإمكان أن تكون في المعارضة، ولكن كان التقدير دائماً تغليب مصلحة البلاد”، مشيرة إلى أنه “كان على القيادات التي ساهمت في صنع السياسات وقادت إلى هذا الوضع من باب المسؤولية الأخلاقية والسياسية أن تتراجع وتستقيل، وتعترف بالمسؤولية، ولكن هذا لم يحصل”.
وبينت المتحدثة أن “الاعتراف بالخطأ موجود نسبياً، ولكنه لا يكفي، فلا بد من أن ترافقه خطوة أخرى نحو البلاد والشعب، وهو ما أردنا أن يحصل بعد هذا الاجتماع”، مؤكدة أنهم أرادوا “خلال هذه الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد أن تدار النهضة بمكتب تنفيذي جديد وتركيبة مصغرة، ومن طريق أشخاص في مستوى التحديات، ولكن هذا لم يحصل، وكان مخيباً للآمال”.
ولفتت إلى أن “أكثر من 20 قيادياً من الشخصيات المعروفة على الموقف نفسه وسيعلنون انسحابهم ورفضهم نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى”.
ولم يصدر بعد أي موقف رسمي أو بيان عن الاجتماع، فيما يلزم كثيرون الصمت مع توقعات بخلافات كبيرة ستكون لها تداعيات على تماسك الحركة.
العربي الجديد
—————————-
تونس .. الانقلاب لم يحصل بعد/ بشير البكر
ثمّة تيار إعلامي عربي يتعامل مع الحدث التونسي على أنه نزاع بين الرئيس قيس سعيّد وحركة النهضة التي تأتي في المرتبة السياسية الأولى في البلاد، كونها صاحبة أكبر فريق برلماني. ويحاول أصحاب هذا الاتجاه تعميم التجربة المصرية ما بعد ثورة 25 يناير، والمآلات التي وصل إليها الوضع في 30 يونيو/ حزيران 2013. هذا تبسيط مقصود للمسألة التونسية، غرضه وضع “النهضة” في مرمى النيران، وتصويرها غير مهيأة لتكون طرفا في أي حكم، أو شراكة سياسية، حتى لو حازت موقع الحزب الأول في البرلمان، كما جرى في انتخابات 2019 بحصولها على 52 نائبا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان (217). وبالتالي، فإن ذلك أمر يتجاوز حدود التجنّي على طرف سياسي، يمثل شرائح وحساسيات من المجتمع التونسي.
انقلاب الرئيس سعيّد لم يحصل في 25 يوليو، ذلك أن فرمان تجميد البرلمان وحل الحكومة يمثل تمهيدا لخطوات لاحقة مدروسة ومحسوبة، على نحو يتيح لها أن تسير بالتتابع واحدة وراء أخرى، على عكس ما هو متعارفٌ عليه من انقلابات كلاسيكية تحصل خلال ساعات، فإما أن تنجح أو تفشل، وشرط نجاحها سيطرة العسكر على الإذاعة والتلفزيون. لم تعد القواعد القديمة سارية المفعول، فقد باتت الانقلابات تجري بطرق ووسائل مختلفة، وما يقوم به سعيّد هو انقلاب بالتدريج، يتجاوز حدود إمكاناته الذاتية. وما يصدر عنه من فرمانات ومواقف ترجمة للإجراءات التي اتخذها في 25 من الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، ويرسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وهذا هو الهدف البعيد الذي يتمثل في تثبيت نظام حكم جديد، من خلال استفتاء شعبي على تعديل دستور 2014، يقوم على حصر السلطات وتركيزها بيد رئيس الدولة. وهو بذلك يلغي التوازن بين السلطات، الذي يشكل منطق الدستور القائم على النظام الرئاسي البرلماني المختلط، ويتجه إلى نظام شبه رئاسي يعطي رئيس الحكومة صفة “وزير أول” ويجرّده من كل الصلاحيات، باستثناء تنسيق عمل الفريق الوزاري تحت إشراف رئيس الدولة، كما أنه يتجاوز دور السلطة التشريعية التي تقوم بمراقبة عمل سلطات الدولة كافة، وفي المقدّمة منها السلطة التنفيذية.
ومهما يكن من أمر، فإنه خارج ثنائية الرئيس و”النهضة” هناك تونس البلد، الذي تشكل تاريخيا وفق خصوصيةٍ حفظت استمراره، بفضل قيامه على توازناتٍ دقيقة جدا، تراعي حجمه وموقعه ومكوناته وموارده الاقتصادية، وهذا سر بقاء البلد الصغير متماسكا بجوار ليبيا والجزائر، البلدين النفطيين الغنيين اللذين يحكمهما العسكر. فالجارة الأولى التي حكمها العقيد معمر القذافي عاشت مع تونس في شد وجذب. وعلى الرغم من محاولاته التأثير على تونس، فإن العقيد لم ينجح، بسبب طبيعة النظام الجمهوري الذي أرساه بورقيبة. أما الجزائر التي لم تمارس لعبة التدخل في تونس، فإنها كانت ترى في الجارة الصغرى بلدا يدور في فلك آخر. وعلى الرغم من محدودية الموارد الاقتصادية التونسية، فإن هذا البلد تمكن من تحقيق حد معقول من الكفاية الغذائية، وأرسى نظاما تعليميا سمح لقطاعات واسعة من الشعب بالوصول إلى التمدّن قبل بقية بلدان المنطقة والعالم العربي. ولذا ليس مصادفة أن تبدأ رياح الربيع العربي من تونس، وأن لا يحمي الجيش نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتسير التجربة الديمقراطية الجديدة أكثر من عشر سنوات بلا خضّات كبيرة، وتتمكّن النخب السياسية من التوصل إلى تفاهماتٍ في كل مرة للخروج من عنق الزجاجة، ومثال ذلك ما بين حزب نداء تونس وحركة النهضة ما بين 2014 و 2019. وعليه، فإن ما قام به سعيّد ويخطط له جديد على التونسيين، ويمكن أن ينقل البلد إلى تجربةٍ ذات عواقب غير محمودة، لأنه يُسقط نتائج صناديق الاقتراع بحركة انقلابية، يلعب الجيش فيها دورا أساسيا من وراء الكواليس.
العربي الجديد
—————————
تونس ما بعد 25 تموز: هل من خارطة طريق؟/ حنان زبيس
تحولت الحياة في تونس إلى “مرحلة انتظار دائم” تتخللها إعلانات يومية عن إيقافات لنواب وإطارات عليا في الدولة، وتنفيذ أحكام قضائية سابقة متعلقة بهم أو فتح تحقيقات في ما يخصهم، وذلك في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس على الفاسدين.
هناك مثل تونسي يقول “توفى السكرة ويحضروا المداينية” أي ينتهي السكر ويحين وقت دفع الديون. هذا المثل يلخص وضع تونس الحالي، فبعد الانتشاء بفرحة إزاحة الإخوان من الحكم عبر قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، جاء وقت التفكير في المرحلة المقبلة أي “ما بعد حركة النهضة”.
مرت أيام منذ إعلان القرارات المصيرية ولم نرَ خطة طريق واضحة لما بعد المهلة التي حددها رئيس الدولة للفترة الاستثنائية بثلاثين يوماً. ينام التونسيون ويصبحون وفي أذهانهم سؤال واحد: ماذا بعد؟
الغموض يكتنف المسقبل والرئيس لا يفصح عما ينوي فعله ولم يختر إلى الآن رئيس حكومة ولا نعرف حتى شكل هذه الحكومة. فهل ستكون حكومة تكنوقراط مصغرة تنكبّ على معالجة المشكلات العاجلة مثل أزمة “كورونا” والأزمة الإقتصادية، كما اقترح “الاتحاد العام التونسي” للشغل أم أنها ستأخذ شكلا آخر؟ وكم سيدوم عمل هذه الحكومة وما أولوياتها؟ وفي حال تم تشكيل الحكومة فمن سيمنحها الثقة والبرلمان مُعلّق؟ ثم هل من حدود “للفترة الاستثنائية” أم سيظل الرئيس يمدد فيها كحالة الطوارئ من دون أفق واضح؟ في الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيد في 29 تموز/ يوليو 2021 بخصوص تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حدد ذلك بفترة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد. ولكن لا أحد يعلم كم من مرة سيتم تجديد هذه الفترة.
هذه الأسئلة لا تنفك تطرحها منظمات المجتمع المدني في تونس التي وإن استبشرت خيراً بقرارات الرئيس لإنهاء منظومة الحكم الفاشلة التي ساهمت في نخر أسس الدولة واستشراء الفساد في كل مفاصلها، فإنها لم تخف تخوفها من تغول رئيس الدولة واستفراده بالحكم بخاصة أنه يجمع في يده حالياً كل السلطات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تراجع عن مكاسب الثورة، تحديداً في ما يخص الحقوق والحريات التي أقرها دستور 2014 والخروج عن الشرعية الدستورية وإنهاء التجرية الديموقراطية في تونس.
وكانت منظمات وجمعيات مثل “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان” و”جمعية النساء الديموقراطيات”، التقت رئيس الجمهورية يوم 26 تموز لتعرب له عن قلقها من إمكانية التفرد بالسلطة وعدم تحديد أجل واضح للإجراءات الاستثنائية.
“لقد أعربنا للرئيس سعيد خلال لقائنا به عن تخوفنا من خطر جمع كل السلطات والانزلاق نحو الحكم الفردي، كما طالبناه باحترام المدة الزمنية المحددة بثلاثين يوماً”، يؤكد جمال مسلم، رئيس “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”، مستئنفاً “نحن ندرك أنه من الصعب أن تكفي هذه المدة لمحاربة الفاسدين وكورونا والأولويات الأخرى التي أعلن عنها قيس سعيد، لذلك نتوقع أنه سيمدد الوقت بثلاثين يوماً أخرى ولكننا سنبقى نتابع بحذر تطور الأوضاع وهو ما جعلنا نكون تنسيقية من الجمعيات لمتابعة تنفيذ القرارات الاستثنائية”.
جاء الإعلان عن هذه التنسيقية خلال اجتماع قامت به 7 منظمات وطنية من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” يوم 27 تموز في مقر “النقابة الوطنية للصحافيين”، وجعلت هدفها العمل المشترك على وضع تصور لخارطة طريق يتم تقديمها في ما بعد للرأي العام التونسي وللرئيس قيس سعيد.
وأعلن “الاتحاد العام التونسي للشغل” أنه جهز خارطة طريق للحكومة المقبلة، ولكنه تراجع عن تقديمها في “ظل حالة الغموض الحالية وعدم الاطلاع بعد على رؤية رئيس الجمهورية لتحديد إن كان معها أو ضدها”، كما صرح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي الخميس 5 آب/ أغسطس لإذاعة “موزاييك” الخاصة. وقد ذهب إلى “ضرورة العودة إلى الشعب والدعوة إلى انتخابات مبكرة”.
مطلب إعلان خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، اصبح المطلب الأساسي والملحّ اليوم للتونسيين، إذ دعا “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” في بيان نشره يوم 4 آب، رئيس الدولة إلى “الإسراع بإعلام الشعب بخارطة الطريق حتى لا تطول الفترة الموقتة وحتى يطمئنّ الشعب على مستقبله ومستقبل البلاد، من دون التخوّف من العثرات الممكنة ومن الفراغ المؤسساتي ومن إمكانية عودة رموز الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء”.
حتى “حركة النهضة” التي تشهد اضطرابات وانقسامات كبيرة حالياً، أصبحت تطالب الرئيس بإلحاح بالإعلان عن خارطة طريق. فقد عبر مجلس الشورى المنعقد يوم 4 آب في بيانه عن انشغاله من “الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب”، وشدد على”ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته”.
لا أحد يعرف حقيقة ما يدور في خلد رئيس الجمهورية، فهو لا يتشاور إلا مع قلة قليلة من الأناس الذين يثق بهم ومنهم مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وأخوه نوفل سعيد: كما أن رئاسة الجمهورية لا تملك ناطقا رسمياً باسمها، ولا يتم تنظيم مؤتمرات صحافية. ولا يتعرف التونسيون إلى توجهات الرئيس إلا من خلال بعض الخطابات التي يلقيها بمناسبة استقباله بعض المسؤولين في الدولة أو ممثلي المجتمع المدني. “هذا يعقد كثيراً عملنا كصحافيين، ويصعب حصولنا على المعلومات الرسمية من رئاسة الجمهورية”، تقول أميرة محمد نائبة رئيس “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين”.
هذا التصرف ليس بجديد على رئيس الدولة، فمنذ توليه السلطة لم يفصح إلا ببعض توجهاته ورؤيته بكلام عام ومبهم عادة لا علاقة مباشرة له مع الواقع. لشهور عدة، ظل يتحدث عن “الفاسدين” و”المتآمرين في الغرف المظلمة” من دون أن يسميهم، إلى حد أن شقاً كبيراً من التونسيين أصبح لا يعير اهتماماً لما يقوله. إلى أن جاءت قرارت 25 تموز لتقلب المعادلة ويصبح كل تونسي معلقاً بكل كلمة تخرج من فم الرئيس. ولكن هذا الأخير بقي كعادته متكتماً حول توجهاته، لا يعلن عن خطواته المقبلة.
هكذا تحولت الحياة في تونس إلى “مرحلة انتظار دائم” تتخللها إعلانات يومية عن إيقافات لنواب وإطارات عليا في الدولة، وتنفيذ أحكام قضائية سابقة متعلقة بهم أو فتح تحقيقات في ما يخصهم، وذلك في إطار الحرب التي أعلنها الرئيس على الفاسدين. ومن وقت إلى آخر، يدعو قيس سعيد التجار إلى تخفيض الأسعار مراعاة للوضع الاقتصادي الصعب، وهو ما لا يتبعه تنفيذ بالضرورة على أرض الواقع.
لكن الوضع اليوم يتطلب إيضاحات لما ينوي قيس سعيد فعله في المرحلة المقبلة، وهو ليس فقط مطلباً داخلياً، إنما أيضاً مطلب خارجي ملح لأن شركاء تونس الاقتصاديين والسياسيين في حاجة لفهم ما إذا كانت الوضعية الاستثنائية ستستمر طويلاً. فتونس التي دخلت في مشاورات منذ أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة لن تستطيع التوصل إلى اتفاق طالما بقيت دون حكومة أو برلمان يشتغل، بل إن وكالة موديز للتصنيف الإئتماني اعتبرت أن غياب المحكمة الدستورية سيؤثر سلباً في الوضع السياسي في تونس وفي المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
في الأثناء، تواصل “النهضة” دعواتها إلى الحوار والعودة إلى المسار الدستوري وسط رفض شعبي لعودتها إلى الحكم والمطالبة بمحاسبة رموزها، لدورهم في مفاقمة الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسهم راشد الغنوسي نفسه، والذي على رغم تقلص نفوذه السياسي حتى داخل حركته، إلا أن كثيرين داخلها باتوا يطالبون برحيله، فإنه لايزال متمسكاً بمنصبه سواء على رأس الحركة أو على رأس البرلمان المعطل.
ويرى مراقبون أن الرئيس قيس سعيد لا نية له للعودة إلى وضع ما قبل 25 تموز، وأنه بالنسبة إليه فإن منظومة الحكم السابقة ببرلمانها وحكومتها وطريقة إدارتها للبلاد انتهت ولا بد من تعويضها بأخرى. بقي أن نعرف ما هي هذه المنظومة الجديدة: بمعنى هل سيظل ضمن دستور 2014 ويدعو إلى استفتاء شعبي على تغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي ليتم تنظيم انتخابات مبكرة بعد ذلك، أم سيعتبر هذا الدستور لاغياً، بما أنه تم تشريعه في فترة كانت فيها “النهضة” تمسك بزمام الحكم، ليعود إلى دستور 1959 بعد تنقيح بعض فصوله لتتماشى مع الوضع الحالي؟
نحن لا نملك سوى الانتظار…
درجة
———————–
تونس.. هل يتورط العسكر؟/ فواز حداد
في معرض الانقلابات، تعود الذاكرة إلى الانقلاب السوري الأول في سوريا، والذي تعرضت إليه في روايتي “تياترو ١٩٤٩”، ما استدعى مني وقتها البحث في أسبابه وفصوله وتداعياته. كان من جملة ما عرفته، هو ما سبقه من قصر نظر بعض السياسيين، بمشاركتهم العسكر في هذا الانقلاب وما أعقبه من انقلابات، فالسياسيون لم يغيبوا تماما عن مسرح العمليات ولا الكواليس، وإن اقتصر في الانقلابات الأخيرة، بعد ما دعي بثورة 8 آذار 1963على سياسيي حزب البعث، وكانوا عسكريين، أو يعملون تحت سلطة العسكر.
ما توضح بجلاء بعد الانقلاب الأول، هو إدراك السياسيين أن البقاء في الحكم لم يعد يضمنه وجود أحزابهم في الحياة السياسية، وإنما بوجود مماثل في الجيش، فكانت هناك شلة الضباط المتعاطفة مع حزب الشعب، وشلة الضباط المؤيدة للحزب الوطني، وهناك من أخذ يستميل ضباط الأقليات الذين بدأت إرهاصاتهم مع الحكم الوطني عقب الاستقلال. وكان من نتائجها، بعد فشل الانقلاب، عدم المطالبة بمحاكمة حسني الزعيم محاكمة علنية عادلة، بل أعدم من دون محاكمة، وإلا لكانت محاكمة للضباط والسياسيين على السواء.
منذ ذلك الحين بات الجيش طرفاً في الحكم، يتدخل في تشكيل الوزارات وانتخابات البرلمان وتحالفات السياسيين والأحزاب، واتخاذ القرارات. وأصبح من المعروف أن كل ضابط كبير محسوب على حزب. إن لم يكن الحزب محسوبًا على ضابط.
لم تعد السياسة سوى وهم كسره العسكريون، أدى إلى تقاسمهم الحكم مع السياسيين قسمة غير متكافئة، سياسيون عزل وعسكر مسلحون. بينما السياسيون غافلون يستقوي بعضهم على بعض بالعسكر، وكما وصفتُ الوضع ملخصًا في الرواية، بأن العسكر يتسيّسون، بينما الساسة يتجيّشون… لكن بلا قوة. وسوف يمضي العسكر قدماً، يعضدهم سياسيون عاجزون، ودائماً سوف تكون هناك حكومة غير قوية، يزيدها العسكر ضعفاً، وعلى الدوام سيجد الضباط عديمو الصبر، أنهم مدعوون للإصلاح بحماسة معززة بإحساس مبالغ فيه بضياع وقت ثمين يُهدر في البرلمان، وتبدده حكومة عديمة الحيلة. بعدئذ يأتي الانقلاب عبر البلاغ رقم واحد، مع أنه تحصيل حاصل.
مع بداية القرن الحالي، عادت الحروب والثورات كآليات للتغيير في المنطقة، ما استولد الانقلابات كأحد أسوأ الحلول لإيجاد صيغة لعدم التغيير، فظهر السيسي في مصر وحفتر في ليبيا، وجاء الإيرانيون إلى سوريا لمنع التغيير والانقلاب معًا، وما زالت دول في انتظار العسكر، فالمنطقة كما بدت مستعصية على الديمقراطية، لكن الآمال كانت منصبّة على تونس، كانت تخوض التجربة الصعبة نحوها، ما يبطل الاستثناء العربي.
لذلك كانت المفاجأة والتساؤلات التي أعقبتها، هل حركة الرئيس قيس سعيّد في تونس انقلابًا؟ إذا كانت كذلك، فليست انقلابا كلاسيكيًا، عمومًا ليست الانقلابات في المنطقة موحدة في التفاصيل، وإن كانت في الطابع، فهي متشابهة، حركة قيس سعيد تشذ عنها إلى حد ما، لم تظهر الدبابات والطائرات بعدُ على الساحة، لكنها تمتّ للانقلاب بصلات قوية من ناحية الخطوات الأولى، في ما يماثل البلاغ رقم واحد، بتقييد العمل الديمقراطي، وذلك بتجميد سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتولي السلطة التنفيذية. ولا يستغرب مساندة أحزاب متطرفة في علمانيتها، تريد التخلص من الإسلاميين ولو ضحت بالديمقراطية، ولا يمكن لهذه الحركة أن تحصد جماهيريتها لولا شعبوية الطرح التي اعتادته الانقلابات، بالركوب على الأخطاء، والتعلل بالفساد، مع أنها لا تلغي الديمقراطية، بالوسع محاربة الفساد مع الإبقاء عليها، إلا إذا كانت الديمقراطية هي المستهدفة.
تتماثل الانقلابات بالوعود التي تغدقها، فالعهد الذي أسقط، سرعان ما يدعى بالعهد البائد، أما العهد الجديد، فمرحلة القضاء على الفساد وإقصاء الفاسدين، ثم تشكيل حكومة تدعى بالحكومة الوطنية، وبرنامج إصلاحي واعد جدًا وغامض جدًا. وإشغال الشعب بتسارع القرارات والأحكام والمحاكمات، نتمنى ألا تكون على نهج الجار المصري، فالإعدامات تتوالى بلا توقف لمجرد أنهم من الإسلاميين، رجال كبار في السن وشبان في عمر الزهور.
ليس من الضروري التقيد بهذه السلسلة، إذ للانقلابات أو ما يشبهها خصوصياتها، لذلك قد نبالغ نحن السوريين الذين اكتوينا بهذا الداء نحو ثلاثة أرباع القرن حتى الآن، الذي خلّف مئات آلاف الضحايا، وما زال الورثة يتسلطون على الناس بالسجون والمعتقلات، ناهيك عن أربعة احتلالات، وبلد خراب ومنهوب، مع فقر وغلاء، وملايين من اللاجئين والنازحين. أما متى تنهض سوريا وتنتصب واقفة، فيصعب التنبؤ، بعد عشر سنوات من الدمار، أقدارها ليست بأيدي السوريين.
نستعيد التجربة السورية، لأن الرئيس قيس سعيد أعلن قراراته بحضور القيادات العليا للجيش والأمن، ما يدل أنه ضمن ليس موافقتها فقط، بل ومساندتها، قبل الإقدام على حركته غير الدستورية. ما يثير التساؤلات حول المؤسسة العسكرية التونسية التي شاركت في إجراءات وقف الحياة الدستورية. ورغم ذلك، تظل موافقتها، وربما مشاركتها المحدودة، ليست دليلا على تغير في السلوك الذي طبع تعاطيها مع الأحداث منذ ثورة 2011، خلالها نأت بنفسها عن التجاذبات السياسية، وإذا كانت قد تورطت باللعبة السياسية، فهذه خطوة قد تكون على طريق طويل، طريق الانقلابات الرحب.
أخيرًا، بافتراض قيام شبهات مع الانقلاب السوري الأول، ألا ينفيها أن الضابط حسني الزعيم كان عسكريًا مغامرًا، صاحب نزوات تسلطية مبكرة، أما الرئيس التونسي فأستاذ جامعي رصين يُدرّس مادة القانون الدستوري. وفي هذا مقارنة طريفة ومرعبة في آن، كيف يجتمع في شخص واحد، أستاذية في الدستور، وفي الوقت نفسه، تفسيره بحيث يجيز الاعتداء عليه؟ ما يمكن أن نستشفه هو أن الطريق سالك أمام العسكر، فهل يتورطون؟
تلفزيون سوريا
—————————
الغنّوشي محور الخلاف… الانقسامات تضرب”حركة النّهضة”/ كريمة دغراش
ألقت الحوادث الأخيرة التي عاشت على وقعها تونس منذ يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، بظلالها على حزب “حركة النهضة” الإسلامي الذي يوصف بأنّه الحزب الأقوى في البلاد، وظهرت خلافاته وانقساماته التي طالما حرص على إخفائها، في تحوّل يؤشر إلى ما قد يكون عليه مستقبله.
وتسببّت الخلافات في تأجيل اجتماع أوّل لمجلس شورى الحزب (أعلى سلطة قرار) إلى ليلة الأربعاء 4 آب (أغسطس)، فيما أعلنت قيادات انسحابها من الاجتماع الثاني، وكتب بعضهم تدوينات يلمحون فيها إلى ما وصفوه بالانفراد بالرأي ومواصلة الهروب الى الأمام، فيما أكّد البيان الختامي للاجتماع “تفهم الحزب للغضب الشعبي” من دون تحميل المسؤولية لطرف بعينه، مع تجديد التأكيد أن ما حدث يوم 25 تموز (يوليو) هو “الانقلاب على الدستور”.
ما قبل 25 تموز وما بعده
يجمع المراقبون للمشهد السياسي في تونس على أنّ “حركة النهضة” قبل 25 تموز لن تكون هي ذاتها بعد 25 تموز. ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية، تتالت الاستقالات والتصريحات الصادرة عن أعضائها، ممن يطالبون بالقيام بمراجعات جذرية وتحمّل مسؤولية ما حدث خلال السنوات الأخيرة.
والأحد الماضي، دعا نحو 140 شاباً من قيادات الحزب، من بينهم خمسة نوّاب، في بيان مشترك إلى حلّ المكتب التنفيذي للحركة.
وقال الموقّعون إن الحزب فشل في تلبية تطلعات التونسيين. وتؤكد مصادر متعدّدة من داخل الحركة لـ”النهار العربي”، أن هناك رغبة لدى كثير من أعضاء الحركة في مغادرة الغنوشي الرئاسة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة المستقيل خليل البرعومي إنّ حزبه يتحمّل مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه الأوضاع في تونس، معتبراً أنّ الوقت قد حان لتغيير وجوه الخطّ الأوّل، وأنه صار من الضروري القطع مع بعض القيادات، بمن في ذلك راشد الغنوشي.
وليس البرعومي أوّل المنتقدين للغنوشي، فقد سبقه إلى ذلك قياديون آخرون، وتقول الكاتبة الصحافية ضحى طليق إن هناك رغبة داخل الحزب في تحميل كامل المسؤولية للغنوشي الذي صار يشكّل حملاً يجب التخلص منه.
وتضيف في تصريح الى “النهار العربي” أن هناك محاولات للقفز من المركب داخل الحركة، بعد تأكد الكل من غرقه.
وطيلة السنوات الأخيرة، وفي وقت كانت فيه أغلب الأحزاب التونسية تعيش على وقع انقسامات داخلية، حافظ حزب “حركة النهضة” على صورة “الحزب القوي المتماسك” الذي لا تعصف به الخلافات، رغم ظهور بعض الأصوات المعارضة لسياسات الحركة ولرئيسها الى العلن.
شعبيّة وهميّة
فشل الحزب الإسلامي في حشد أنصاره في الشارع “للدفاع عن الديموقراطية” و “التصدي للانقلاب”، كما جاء في نص الدعوة التي أطلقها الغنوشي ليلة الخامس والعشرين من تموز، ويؤكد كثيرون أن هذا الفشل كشف حجم الشعبية الحقيقة للحركة، بعيداً عمّا كان الحزب يروّجه ويدّعيه.
ويشدّد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي رافع طبيب، في تصريح الى “النهار العربي”، على أن ما سقط يوم 25 تموز هو واجهة حزب ”حركة النهضة” والأحزاب المتحالفة معه، لافتاً إلى أنّ هذا الحزب انتهى من الداخل منذ فترة.
ويرى أنّ “النهضة”، لسنوات عديدة، أوهمت التونسيين والرأي العام الدولي بأنّها الحزب الأقوى والأكثر شعبية، وظلت تعيش على هذا الوهم، لكن خروج الشباب المحتجّ الذي نادى بإسقاط كامل منظومة ما بعد 2011 (حكماً ومعارضة شكلية) عرّى حقيقتها، فبانت عاجزة عن التعبئة الجماهيرية، حتّى في المناطق التي تعتبر عادة معاقل لها.
ويضيف طبيب أن الحركة نجحت في وقت ما في تقسيم التونسيين إلى علمانيين وإسلاميين، فيما بيّنت حركة 25 تموز أنّ المعيار الوحيد للتقسيم هو ”مع الفساد أو ضدّه”.
التموقع الخارجي
لا تقف ارتدادات حوادث يوم 25 تموز على ”حركة النهضة” عند مكانتها داخلياً، إذ ستكون لها تداعياتها على صورتها في الخارج. فالحزب المرتبط بتنظيم “الإخوان المسلمين” نجح في السنوات الأخيرة في ربط شبكة من العلاقات الدولية القوية، وصار يسوّق لنفسه كنموذج ناجح للحزب الإسلامي القادر على الانصهار في الديموقراطية.
وتقول طليق إن وضعية حزب ”حركة النهضة” مرتبطة بالتوازنات على المستوى الدولي والإقليمي، ومدى دعمها لمسار الرئيس سعيد. لكنها تستبعد اندثار الحزب، مؤكدة أنه سيواصل نشاطه السياسي من دون أن يكون في صدارة المشهد، وأن سيناريو مصر لن يتكرر في تونس، “فرغم أن النهضة تشترك مع إخوان مصر في الأدبيات، إلا أن خصوصية المشهد المصري تختلف عن خصوصية المشهد التونسي”.
النهار العربي
————————–
اللحظة الفارقة تدرك “النهضة”… التراجع المفاجئ يسبب انشقاقاً بالحركة/ هاجر عبيدي
عقدت حركة النهضة مساء الخميس 5 أغسطس/ آب مؤتمراً صحافياً، للرد على تعليقات تداولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية حول انشقاقات بالحركة، عقب بيانها الأخير الصادر أمس الأربعاء، 4 أغسطس/ آب، والذي تراجعت من خلاله الحركة عن موقفها المبدئي الرافض لقرارات الرئيس قيس سعيد، المعلنة في 25 يوليو/ تموز المنقضي.
وكررت قيادات بالحركة خلال المؤتمر تفهمها لغضب الشارع التونسي، إلا أن منذر الونيسي عضو مجلس شورى النهضة ومقرر لجنة الحوكمة والشفافية، قال خلال تصريحاته إن الحركة لا تزال تعتبر قرارات الرئيس التونسي “خرقاً للدستور وانقلاباً على المؤسسات” وهو تصريح أكثر مباشرة وصراحة مما ورد في البيان الصادر عن الحركة ليلة أمس.
وأعلنت حركة النهضة أمس، الأربعاء، قبولها المشروط لقرارات سعيد. وقال قائدها راشد الغنوشي في تصريحات رسمية، إن قرارات سعيد التي أصر على اعتبارها “استيلاء الرئيس على السلطة”، يمكن أن تعد “فرصة للإصلاح”. وإن أشار البيان إلى “تداعيات تلك القرارات التي مسّت القضاء والإعلام والإدارة، ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات”.
جاءت تصريحات الغنوشي عقب اجتماع عقده مجلس شورى الحركة “للتداول في الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد” على خلفية قرارات سعيد المعلنة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المنقضي. والتي علق بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعيّن رئيس حرسه الرئاسي قائماً بأعمال وزير الداخلية، كما تولى سعيد نفسه منصب المدعي العام.
وأعرب شورى النهضة عن “تفهمه للغضب الشعبي”، محملاً “الطبقة السياسية” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مشدداً على اقتناع الحركة بضرورة النقد ذاتي لسياساتها خلال المرحلة الماضية، و”القيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها تفاعلاً مع الرسائل التي عبّر عنها الشارع التونسي”.
كررت قيادات بالحركة خلال المؤتمر تفهمها لغضب الشارع التونسي، إلا أن منذر الونيسي مقرر لجنة الحوكمة والشفافية، قال إن الحركة لا تزال تعتبر قرارات الرئيس التونسي “خرقاً للدستور وانقلاباً على المؤسسات” وهو تصريح أكثر مباشرة وصراحة مما ورد في البيان الصادر عن الحركة ليلة أمس.
إلا أن قيادات الحركة أعربت من خلال البيان عن قلقها من “الفراغ الحكومي، وعدم تكليف رئيس الدولة شخصية مناسبة تشكيل الحكومة”. وأكدت القيادات نفسها استعدادها “لتقديم التنازلات اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة، شريطة العودة للمسار الديمقراطي واحترام الدستور”.
ليسوا على قلب رجل واحد
كان راشد الغنوشي قد اعتبر – سابقاً- الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد “انقلاباً على الشرعية والدستور”، ثم عاد وأعلن في تصريحات الأخيرة اعتقاده بإمكانية الإصلاح عبرها. هذا التغيير المفاجئ أثار ردود فعل متباينة وسط الحركة بين مؤيد ومعارض، حتى أن بعض القيادات أعلنوا انسحابهم من اجتماع مجلس الشورى، ومنهم النائبة جميلة الكسيكسي دبش، التي أعلنت في تدوينة أنها غير معنية بأي قرارات تنبثق عن مجلس شورى النهضة الذي يترأسه الغنوشي.
كذلك أعلنت النائبة يمينة الزغلامي في تدوينة على صفحتها في فيسبوك انسحابها من اجتماع مجلس الشورى واعتراضها على قراراته. وسبق للزغلامي أن هاجمت الغنوشي قبل أيام واعتبرته “يهدد السلم الاجتماعي”، بحسب تصريحات نقلتها قناة العربية الممولة سعودياً والتي تبث من الإمارات. والدولتان معروفتان بعدائهما لحركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها فكر النهضة.
الزغلامي في تنصلها من بيان الحركة قالت إن هذا البيان يأتي “نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد”.
إلا أن مؤتمر اليوم نفى وجود انشقاقات واسعة، كما نفى ما تداولته وسائل إعلام عربية بشأن وجود ضغوط واسعة داخل الحركة لعزل الغنوشي.
اتفاق على التهدئة
في سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني لرصيف22 أن الدورة 52 لمجلس شورى الحركة “ثبتت الموقف المبدئي للحركة من القرارات الرئاسية باعتبارها “انقلاباً على الدستور وخرقاً جسيماً له، لكنها قدرت أن تلك القرارات لقيت بعض الدعم والاستحسان في أوساط أخرى، وصارت أمراً واقعاً. وبالتالي لا بد من التعامل معها بمرونة للخروج من الأزمة الراهنة وإنهائها”.
وأضاف القوماني أنه تم خلال الاجتماع تسجيل الحركة من الفراغ القانوني والدستوري الناجم عن غياب مؤسسات حكم أساسية كالبرلمان ومنصب رئيس الحكومة، مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تكليف الشخصية الموكول إليها تشكيل الحكومة، “وعرضها على البرلمان، والإسراع في مباشرة مهامه في مجابهة الأزمتين الاقتصادية والصحية”.
يذكر أن البرلمان مجمد حتى نهاية 25 أغسطس/ آب بموجب قرارات سعيد، كما أن الرئيس أوكل إلى الجيش مهمة مجابهة الأزمة الصحية المتمثلة في ارتفاع معدلات الإصابات الجديدة والنشطة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه.
وبيّن القوماني أن قيادات النهضة عبّرت عن استعدادها لـ”التفاعل الإيجابي” مع أي مقترحات تساعد على العودة لعمل البرلمان، وتغيير أولوياته، وتحسين أدائه بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأشار المتحدث إلى أن فحوى البيان تم الاتفاق عليه بالإجماع، وهو ما تنفيه تصريحات لنائبتين على الاقل حضرتا الاجتماع، “لكن حصل اختلاف في الحركة حول حل المكتب التنفيذي الحالي الذي تشكل قبل ستة أشهر، وتقرر عرض المقترح على التصويت الذي أسفر عن رفض [مقترح] حل المكتب لضعفَيْ [عدد] المؤيدين له”.
خلية أزمة
على خلفية تسجيل اختلاف في الآراء، نجم عنه انسحاب قيادات من مجلس الشورى، أفادت الناطقة الرسمية باسم شورى النهضة سناء المرسني لرصيف22 بأنه تقرر تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأضافت المرسني أن الخلية ستعمل على التفاوض مع الأطراف المختلفة داخل الحركة، وتحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
رصيف 22
—————————-
=====================
تحديث 07 آب 2021
————————–
هوامش على دفتر الأزمة التونسية/ حسن نافعة
أقدم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، في 25 الشهر الماضي (يوليو/ تموز) على اتخاذ جملة من التدابير والقرارات، شملت: تجميد اختصاصات المجلس النيابي شهراً، وضع سلطة النيابة العامة تحت إمرته وسلطته المباشرة، إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، تمكينه من سلطات السلطة التنفيذية، بجناحيها الرئاسي والحكومي، وصلاحياتها كافة، بما في ذلك منح نفسه سلطة منفردة لتعيين رئيس الحكومة وإقالته، وتعيين الوزاء بناء على اقتراح الأخير. ويعترف رئيس الجمهورية التونسية أن التدابير التي تم اتخاذها هي بطبيعتها “استثنائية”، ومن ثم مؤقتة. وبرّر اللجوء إليها بوجود خطر داهم يهدّد سلامة الدولة والمجتمع، من وجهة نظره، ويفرض على رئيس الدولة مسؤولية مواجهته، ولو بغير الطرق التقليدية أو الطبيعية. لذا يرى قيس سعيد أن ما قام به لا يعد انقلاباً على النظام الديمقراطي، أو خروجاً على القانون، وأنه تصرّف في حدود ما تقضي به المادة 80 في الدستور التونسي.
تنص المادة 80 من الدستور على: “لرئيس الجمهورية، في حالة وجود خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيانٍ إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقتٍ بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلبٍ من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرّح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب”.
ويتّضح من المقابلة بين النص الحرفي لهذه المادة وما تم اتخاذه بالفعل من قراراتٍ وإجراءات استثنائية أنها تسمح بتأويلاتٍ شتى، قد لا تتطابق بالضرورة مع التفسير الشخصي الذي استند إليه قيس سعيّد، باعتباره أستاذاً للقانون الدستوري قبل أن يكون رئيساً للدولة. ومن ثم، فنحن هنا إزاء قضية خلافية تتعلق بمدى دستورية القرارات والإجراءات المتّخذة، وهي قضيةٌ يستحيل حسمها إلا عبر صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، جهة الاختصاص الوحيدة المنوط بها الفصل في مثل هذا النوع من المنازعات. ولأن هذه المحكمة لم تشكل في تونس بعد، بل ويعدّ غيابها جزءاً من الأزمة السياسية المحتدمة حالياً، من المستبعد تماماً أن يؤدّي الجدل الدائر، بشأن مدى دستورية التدابير والقرارات التي صدرت بالفعل، إلى العثور على مخرجٍ من أزمةٍ عميقة يمر بها النظام التونسي حالياً. لذا، القضية الجوهرية التي ينبغي أن تنشغل بها كل أطراف المعادلة السياسية في تونس يجب أن تدور حول كيفية معالجة الأزمة الأصلية التي دفعت الرئيس قيس سعيد إلى اتخاذ “تدابير استثنائية”، وليس حول البحث في مدى دستورية هذه التدابير أو عدم دستوريتها، فالعبرة، في النهاية، تتعلق بمدى فاعلية هذه التدابير والإجراءات، وبالتالي قدرتها على إخراج النظام السياسي التونسي من مأزقه الراهن، وليس حول مدى دستورية أو التدابير والقرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها أخيراً أو عدم دستوريتها.
معروفٌ أن تجربة التحول الديمقراطي في تونس، وهي الوحيدة التي أفلتت من كوارث ألمّت بتجارب مماثلة انطلقت مع “ثورات الربيع العربي” منذ أكثر من حقبة، نجحت في إقامة نظام ديمقراطي مكتمل الأضلاع، يتضمن دستوراً تم تبنّيه بالتوافق والرضى العام، ورئيساً للدولة منتخباً بالاقتراع المباشر، وسلطة تشريعية ممثلة لأغلب، إن لم يكن جميع، القوى والتيارات السياسية والفكرية في المجتمع التونسي. الأهم أن هذا النظام الديمقراطي شكلاً استطاع، على الرغم مما مرّ به من تقلبات وتجاذبات ومنعطفات حادّة، توفير مناخٍ من الحريات العامة وكفالة حقوق الإنسان تحسُده عليه كل الدول والأنظمة العربية الأخرى. ولكن سرعان ما تبيّن أن توفر معظم متطلبات الشكل الديمقراطي في النظام الحاكم لا يضمن، بالضرورة، قوة الدولة التي يديرها هذا النظام، ولا فاعليتها وكفاءتها، ما أدّى إلى تعرّض الدولة التونسية، أخيراً، خصوصاً في ظل استمرار جائحة كوفيد 19، إلى هزّاتٍ تنذر بانهيارات سياسية واجتماعية وصحية حادّة، وتفسّر، إلى حد كبير، لجوء الرئيس قيس سعيّد إلى الإجراءات والقرارات الاستثنائية التي اضطر لاتخاذها أخيراً.
أُدرك أن تجربة التحول الديمقراطي في تونس تختلف جذرياً عن مثيلتها في مصر، فالدور السياسي للجيش المصري يختلف تاريخياً عن مثيله التونسي. ويتمتع المجتمع المدني في تونس بالقوة والحيوية اللتين تمكنانه أحياناً من لعب أدوار سياسية إنقاذية، يصعب على المجتمع المدني في مصر أن يقوم بها. وتتمتع حركة النهضة التونسية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بدرجةٍ من النضج السياسي تضفي عليها براغماتية فكرية وحركية تمكّنها من تجنّب الصدام في أحيان كثيرة، وهو ما لا يتوفر بالقدر نفسه لجماعة الإخوان في مصر. وعلى الرغم من ذلك كله، لا أستطيع مقاومة إغراءٍ يدفعني إلى عقد مقارنة بين ما اتخذه رئيس الدولة التونسي أخيراً من قرارات وإجراءات “استثنائية” و”إعلان دستوري” كان رئيس الدولة المصري في ذلك الوقت، محمد مرسي، قد أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012. المفارقة هنا أننا إزاء رئيسين، وصلا إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، لكن أحدهما، قيس سعيّد، يعد شخصية مستقلة تنظيمياً ومنتمية فكرياً للتيار “العلماني”، أما الآخر، محمد مرسي، فشخصية منخرطة تنظيمياً ومنتمية فكرياً لتيار “الإسلام السياسي”. ومع ذلك، اختلف رد فعل القوى المناوئة أو المؤيدة لهما على ما اتخذاه من إجراءاتٍ في الحالتين، فعندما كان تيار الإسلام السياسي في موقع الحكم وممارسة السلطة، كما في حالة مرسي، اتخذ موقفاً مدافعاً بشدة عن قراراتٍ وإجراءاتٍ أدت إلى تركيز السلطات الثلاث في يد رئيس الدولة، بدعوى أنه رئيس منتخب ديمقراطياً، وبالتالي يعبّر عن إرادة الشعب، وأن ما اتخذ من إجراءات استثنائية كان ضرورياً لمواجهة مؤامرات “الدولة العميقة” التي قيل إنها كانت تعد لثورة مضادّة في ذلك الوقت. ولأنها لم تكن حجّةً مقنعة لباقي التيارات السياسية والفكرية، فقد رأت فيها الأخيرة دليلاً على أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الانفراد بالحكم وسرقة مكتسبات الثورة، ما شكّل نقطة انطلاق لسلسلة احتجاجات جماهيرية، راحت تتسع إلى أن انفجرت في مظاهراتٍ ضخمة اندلعت في 30 يونيو/ حزيران 2013، واستغلها الجيش لعزل الرئيس المنتخب، وإجهاض التجربة الديمقراطية في مصر بالكامل.
الصورة اليوم في تونس معكوسة تماماً، فالرئيس الذي لجأ إلى إجراءات استثنائية ينتمي، هذه المرّة، إلى التيار “العلماني”، بينما تنتمي القوى المناوئة له إلى تيار الاسلام السياسي الذي تقوده حركة النهضة التي لم تتردّد في وصف الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها قيس سعيّد انتهاكاً للدستور وانقلاباً على الديمقراطية، من دون أن يشفع له كونه رئيساً وصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ومن ثم يفترض أن يكون معبّراً عن إرادة الشعب التونسي ككل. وقد خطر لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن يدعو أنصاره في البداية إلى مقاومة “الانقلاب” عبر تحريك الشارع، لكنه تراجع فيما بعد لحسن الحظ، ولو فعل لارتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين في مصر وانتهى بكارثة كبرى، خصوصاً وقد بدا واضحاً أن الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها سعيد تحظى بتأييد ملحوظ، ليس فقط من تيار سياسي تونسي عريض، ولكن أيضاً من الجيش والأجهزة الأمنية.
تخوض تجربة التحوّل الديمقراطي في تونس محنة كبرى في هذه المرحلة، نتمنّى أن تخرج منها معافاة ومحافظة على مكتسباتها الرئيسية، وفي مقدمتها المكتسبات الخاصة بتوفر الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، فقد ثبت أن النظام الذي أفرزته التجربة التونسية لم يكن قابلاً للاستمرار أو قادراً عليه، بسبب صراعات مريرة ومستمرّة بين رئاسات الدولة والحكومة والبرلمان، فقد أدّت التجاذبات المستمرة فيما بين هذه الرئاسات إلى شلل الدولة، وعطّلت قدرتها على الاستجابة إلى طموحات المواطن التونسي في التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية. لذا تبدو الحاجة ماسّة إلى خريطة طريق واضحة تسمح بالخروج السريع من تلك الهوّة السحيقة التي وقعت فيها النظام، وهو ما يضع كلا من المجتمع المدني التونسي وحركة النهضة أمام اختبارٍ نأمل أن ينجحا فيه.
نجاح تجربة التحول الديمقراطي في تونس مسألة حيوية، لأنها لا تهم تونس وحدها، وإنما تهم العالم العربي كله.
العربي الجديد
————————————
ليس الوضع التونسي بذلك السواد/ محمود الريماوي
لا يدري المرء سر التفاؤل النسبي إزاء الأحداث التي ما فتئت تونس تشهدها منذ 25 الشهر الماضي (يوليو/ تموز) مع إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائية (أوامر رئاسية)، شملت تجميد مجلس النواب ثلاثين يوماً قابلة للتمديد واستدعاء بعض النواب “المجمّدين” للتحقيق على خلفية قضايا قديمة، وإقالة نحو 30 من كبار المسؤولين، منهم مدير المخابرات ورئيس الحكومة والسفير في واشنطن ووالي صفاقس (ثاني أكبر مدن البلاد)، ودعوة 460 من رجال الأعمال وغيرهم إلى صلح جزائي جزاء مخالفات وتجاوزات جسيمة على المال العام وفق تقارير رسمية. هذه أهم الإجراءات، حتى صبيحة الخميس 5 أغسطس/ آب الجاري، وهي تدابير وأوامر أثارت حفيظة النخب، ووضعت هؤلاء في موقع المناوأة لها والتحذير منها، ومما قد يتبعها من إجراءاتٍ تُكمل مساراً انقلابياً، يضع السلطات جميعها بإمرة رئيس البلاد. وفي “وقفة تأمل مع الذات”، يتراءى أن سرّ التفاؤل يكمن في عدة أمور، أغلبها ظاهر للعيان والقليل منها مستتر.
الأمر الأول أن الهبّة الجماهيرية المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد تمحورت حول تأييد إجراءات مكافحة الفساد، وإدانة عجز النخب الحزبية عن إدارة نظام ديمقراطي متسق ومثمر، وتأييد كسر الحلقة المفرغة. ومن حق الناس أن تكون لهم كلمة في ما يجرى، وتقدير موقف خاص بهم أسوةً بالنخب والمتنفذين مالياً ونيابياً وإعلامياً. وقد لوحظ أن الأحزاب النافذة سرعان ما بدّلت نبرتها الناقمة والناقدة على الإجراءات، وباتت تنحو نحو التواضع والاعتراف بالأخطاء وأوجه القصور. وما كان لحملة النقد الذاتي هذه أن تتم لولا تأييد شعبي واسع للقرارات الرئاسية، والإدراك المتنامي أن أداء الأحزاب من “النهضة” إلى الحزب الدستوري الحر، مروراً بـ “قلب تونس” وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وغيرها، قد أسهم في انفجار الأزمة على النحو الذي انفجرت فيه، وطاولت شظايا الانفجار المنظومة جميعها (على غرار “كلّن يعني كلّن” في لبنان).
لقد اغتنم الرئيس سعيّد قيام موجة احتجاجات ساخطة، وعلى جانبٍ من العنف، وما صاحبها من أجواء سياسية، كي يخرج بقراراته، وبما يوحي أن الإجراءات جاءت استجابة للهبّة الشعبية وترجمة لمخرجاتها، وهو ما ينسجم مع خطاب الرئيس بعروةٍ وثقى تربطه بـ”الشعب”، وبما يتفق مع رؤيته لتوجّهاتٍ تصعد من الأسفل، ويجرى تبنّيها في المواقع العُلوية. ومؤدّى ما تقدّم أن مكافحة الفساد وتطهير الإدارة من المنتفعين والمرتكبين وعدم الارتهان إلى نظام نيابي غير منتج هي من عناوين المرحلة المقبلة، إضافة إلى عناوين أخرى.
الأمر الثاني الذي يثير تفاؤلاً نسبياً أن ثمّة تمسّكاً عاماً بالمسار الديمقراطي، وما يشبه الإجماع على رفض الديكتاتورية، ورفض العودة إلى الوراء تحت مسميات وشعارات برّاقة. وقد التقى على ذلك الفاعلون السياسيون والاجتماعيون والأكاديميون. وهذه مسألةٌ سياسيةٌ ودستوريةٌ في غاية الأهمية، تقطع الطريق على أية ثورة مضادّة، مهما كان مصدرها وذرائعها ولبوسها. وهي غاية أية خريطة طريقٍ منتظرةٍ للمرحلة الراهنة، ولمستقبل النظام السياسي في هذا البلد الفتي. وتشكّل بطبيعة الحال قيداً على من يحاول استغلال الظروف الحالية من أجل النكوص إلى الوراء، ولحرمان شعب تونس من ثمرات ثورته الطليعية عام 2011 التي افتتحت عهداً جديداً في الحياة السياسية العربية، وأعادت الاعتبار لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
الأمر الثالث الذي يشيع موجة من التفاؤل أو الاطمئنان الحذر هو تفادي التيارات السياسية والاجتماعية اللجوء إلى العنف، وتركيزها على السلم الاجتماعي، وإبداء حرصها الشديد على مرافق الدولة ومؤسساتها، وهذه في النهاية ملك للجميع. وفي ذلك بعض من النقد الضمني لمظاهر العنف التي شابت موجة الاحتجاجات الشعبية خلال الأسبوعين السابقين على القرارات الرئاسية. وقد طاول النقد أيضاً أسلوب التوقيفات، وما اتسم به أحياناً من ترويع للعائلات والبيوت الآمنة، وكذلك عدم تحديد أماكن التوقيف والجهة المولجة بهذه الإجراءات، علاوة على افتقاد مذكراتٍ قضائيةٍ لتنفيذ تلك الإجراءات، فالمطلوب، في النهاية، إنفاذ العدالة في أجواء طبيعية آمنة، وحفظ حقوق من طاولتهم هذه الإجراءات وكرامتهم.
وهكذا، تتضافر المؤشرات السلبية والإيجابية، وتضع الغالبية الاجتماعية في حال مزيج من الاستبشار، ومن البلبلة واللايقين والحذر الشديد مما هو آتٍ، غير أن المرء يرغب هنا في البناء على المؤشّرات الإيجابية التي تم التطرّق إليها، وذلك من أجل بلورة رؤية واقعية للمسار المستقبلي، وبما يتعدّى احتقانات المرحلة الحالية، والمأمول أن تكون هذه آنيةً ومؤقتة. ولنا أن نلاحظ، في هذا السياق، أن الرئيس سعيد يشدّد دوماً على التزامه بالمسار الديمقراطي والحريات والحقوق الفردية والاجتماعية، وينفي عن شخصه أية نزعة ديكتاتورية أو انقلابية. ومع أن الديكتاتوريين ينكرون عادة هذه الصفة عن أنفسهم، ويرون في ذواتهم زعماء وطنيين يستجيبون لتطلعات الشعب، إلا أن المرء يحسب، على الرغم من ذلك، أن الرجل يؤمن حقاً بالمسار الديمقراطي، ولكن بعد “تصحيح” هذا المسار دستورياً، بتعديل الدستور وطرح الأمر على استفتاء شعبي. ومحور التعديل هو الانتقال إلى نظام رئاسي، كما فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أربع سنوات. ويستدلّ على ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة المفصلية، في ما يواظب عليه الرئيس من تذكيرٍ بصلاحياته، وعلى نحو يشي بأن النظام البرلماني يسلبه هذه الصلاحيات. وللقوى السياسية والاجتماعية، ومنها على الخصوص الاتحاد التونسي للشغل والمنظمات الحقوقية الرئيسية والشخصيات القانونية، أن تحدّد ضمانات للمستقبل، بحيث لا يودي أي خيار مستقبلي بركائز المسار الديمقراطي، ومن هذه الضمانات إنشاء محكمة دستورية في أجواء بعيدة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية، والاهتداء بأفضل التجارب الديمقراطية في عالمنا، انسجاماً مع مكانة تونس الدولية، ولضمان حق الشعب في إرساء نظام ديمقراطي لا يفتئت على أحد أو مجموعة، ولا يماري أو يقصي أحداً أو جماعة، ولضمان إغلاق الطريق أمام أي فرد أو أي طرف لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وعلى سبيل المثال، وإذا ما تم الذهاب إلى خيار استفتاء على نظام رئاسي، فإن لهذا النظام أكثر من صيغة، فليس النظام الرئاسي الفرنسي، ولا الأميركي، على شاكلة النظام الروسي الرئاسي مثلاً أو غيره من أنظمة ديكتاتورية مُقنّعة أو سافرة.
وعدا ذلك، خسر مجلس النواب الكثير من التزكية الشعبية، وقد تفرض الظروف قريباً إدخاله في عطلة نيابية، يليها حلّه، والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل قانون انتخابي متفق عليه، وتعقبها حُكماً انتخابات رئاسية من أجل نقلة متوازنة للبلاد إلى مرحلة جديدة، وبالإفادة من دروس العامين الأخيرين، وبخاصة الأسابيع الأخيرة.
العربي الجديد
———————–
النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي
تونس: أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد.
هل ستنهض النهضة؟
عادت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، إلى الحياة السياسية في تونس إثر ثورة 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا في العام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية في العام 2019.
وظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء راشد الغنوشي البالغ من العمر 80 عاما على رأس الحزب منذ أربعين سنة.
ومع إعلان الرئيس قيس سعيّد قراراته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة ثلاثين يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب الى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية.
ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية على خلفية الأزمة السياسية الوطنية، قد تهدد موقع الحزب في المشهد السياسي.
ورد الحزب على سعيّد باعتبار قراراته “انقلابا على الثورة والدستور”، ودعا أنصاره للخروج للتظاهر و”الدفاع عن الشرعية”، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الدعوة، تجنبا للعنف، كما قال.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحنّاشي لوكالة فرانس برس “لن تكون النهضة كما كانت منذ العام 2011. هذا أكيد. ستكون أضعف”، معلّلا ذلك بحدة “الزلزال الداخلي” بين من يدعم بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعوه لرحيله.
غير أن الغنوشي المعروف بدهائه السياسي، قال في مقابلة مع فرانس برس إن حزبه “مستعدّ لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديموقراطية”.
ويرى الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي أن “ما حدث مع الرئيس أظهر النهضة في حالة ضعف كبير، لم تعد ممسكة بخطوط اللعبة السياسية عكس ما كانت عليه في الماضي”.
ويضيف أن “تحجيما للدور السياسي للحزب” قد يحصل، “لكن إقصاءه تماما من المشهد صعب”. ويضيف “لديها من الانغراس والعمق الشعبي ما يسمح لها بمواصلة تواجدها”.
كيف ستخرج من الأزمة؟
قرّرت النهضة عندما كانت في الحكم في العام 2013 وإثر أزمة سياسية حادة أججتها اغتيالات سياسية طالت معارضين لها، الخروج من الحكم والمشاركة في حوار وطني انتهى آنذاك بتشكيل حكومة تكنوقراط.
إثر ذلك ومن أجل ضمان البقاء في السلطة، شكلت ائتلافا “هجينا” مع حزب “نداء تونس” الليبرالي العلماني في العام 2014، وتقرّبت من رئيسه الراحل الباجي قائد السبسي. في انتخابات 2019، تحالفت مع حزب “قلب تونس” الذي يلاحق رئيسه نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال.
ويملك حزب النهضة خبرة “وقدرة على التكيّف مع الأزمات وامتصاصها، لأنه مهيكل ومنظم”، حسب الحنّاشي. وخفّف مجلس الشورى في الحزب بعد اجتماعه الخميس من حدة خطابه ضد سعيّد، ودعاه الى حوار وطني وتعيين رئيس حكومة جديد، وأقر بضرورة القيام بمراجعات لسياسة الحزب المنتهجة في السنوات الأخيرة وتحمّل مسؤوليته واستعداده للاعتذار عن الأخطاء المرتكبة.
وهذه الخطوة في تقدير الحنّاشي “انحناء للعاصفة لتجاوزها”.
لكن سعيّد يشدد على أنه “لا رجوع إلى الوراء”.
ما مستقبل الغنوشي؟
يمثّل الغنوشي الذي يقدّم نفسه “إسلاميا ديموقراطيا” البعد الرمزي القوّي للإسلام السياسي في البلد الوحيد الذي نجا من تداعيات ما وصف “بالربيع العربي” مقارنة بدول أخرى انتهت إلى فوضى أو إلى عودة الدكتاتورية.
ويرى أنصاره أن له فضلا كبيرا في نجاح بقاء الحركة في السلطة طيلة السنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال الديموقراطي في البلاد، بينما ينتقد آخرون “سلطته الأبوية” على الحزب الذي أصبح “مشروعا شخصيا” له ودفع العديد من القيادات، على غرار حمادي الجبالي ولطفي زيتون وعبد الحميد الجلاصي وزبير الشهودي، إلى الاستقالة.
وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب في العام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علّل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة.
ويقدّر الحناشي أن الغنوشي “سيخرج ولكن في صورة مشرفة له”، لأنه “أصبح عبئا على جزء من النهضة وقياداتها”.
ويوضح الخلفاوي أن “مستقبله كلاعب سياسي متصدر المشهد السياسي انتهى وأصبح من الماضي”، مستبعدا إقصاءه تماما، لأن “القوى الإقليمية والدولية ليست مُجمعة على ذلك”.
(أ ف ب)
القدس العربي
————————
موقع بريطاني: لهذا أيام “انقلاب تونس” معدودة.. ومصدر جزائري: نعرف كيف نفّذته مصر والإمارات
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الذي يديره، إن “انقلاب” الرئيس التونسي قيس سعيّد ستكون أيامه معدودة، لمعارضة الدول الغربية له وكذلك الجارة القوية الجزائر، بالإضافة لتركيا رغم الدعم الذي يجده من مصر ودولة الإمارات.
ونقل هيرست عن مصدر جزائري، وصفه بالرفيع، قوله “ليس لهذا الانقلاب أفق للنجاح. طالبنا قيس سعيّد بالتفاوض مع الغنوشي، ونعرف بالضبط كيف نفّذ المصريون والإماراتيون هذا الانقلاب. لا نريد أن نرى حفتر آخر في تونس. لا نريد أن نرى حكومة في تونس تابعة لهذه القوى”.
وأكد الكاتب أن هذا “الانقلاب” يفقد الزخم ولا يحصل على الدعم الذي يحتاجه لإدارة البلاد، وتدرك دوائر أوسع، وأوسع من التونسيين في الداخل، الآن من الذين يديرون الدولة والحكومة والقضاء.
وأضاف أن الدعم المالي الخارجي لقيس سعيّد غير محتمل، وهو أمر مهم لبلد صغير مفلس مثل تونس، التي لا تستطيع دفع فاتورة أجور القطاع العام الضخمة وتدين بسداد ديون خارجية بلغت 6 مليارات دولار مستحقة الدفع هذا العام وحده.
ونقل هيرست عن مصادر تونسية وإيطالية أن سفراء من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة طلبوا من الرئيس التونسي إعادة البرلمان بأسرع ما يمكن، وأن الأميركيين منعوه من تنظيم مسيرة حاشدة لصالح الاستيلاء على السلطة، ونقلوا جميعهم رسائل دعم إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة، بالإضافة إلى قادة حزبيين آخرين.
وقال الكاتب إن سعيّد قد يميل إلى تجاهل كل هذا، الآن بعد أن يعتقد أن لديه تأكيدات من مصر ودولة الإمارات بأنهم سيمولونه، “لكن قبل قبول هذه الوعود المالية على أنها حقيقية، عليه أن يسأل السودانيين عن تجربتهم مع مثل هذه الوعود”.
وأكد الكاتب أن الجزائر هي التي يجب أن يقلق سعيّد بشأنها أكثر. فتونس بلد صغير لديه جيران كبار، “لا مصر ولا الإمارات، من نظمتا ومولتا هذا الانقلاب على التوالي” ضمن الجيران الذين يجب أن يقلق الرئيس التونسي بشأنهم.
وقال إن “الجزائر تعتبر تونس ساحتها الخلفية وبوابتها إلى طرابلس، ولها مصلحة إقليمية واضحة في الأحداث في كل من تونس وليبيا. وبعد أن فشل الإماراتيون في ليبيا، يحاولون الآن تحقيق الغايات نفسها في تونس، أو على الأقل هكذا يراها الجزائريون”.
وأشار الكاتب أن الحكومة التركية تشعر بالقلق كذلك إزاء الأحداث في تونس، لأسباب ليس أقلها الشعور بأن الانفراج الأخير بين مصر والإمارات مع أنقرة يمكن أن يكون حيلة لإلهاء تركيا عن الفعل الحقيقي، الذي كان تحركا ضد تونس.
لكن في تونس العاصمة، يقول هيرست، سعيّد لا يستمع، والدبلوماسيون الإيطاليون يشكون من أنه لا يفهم أن الديمقراطية تعددية، ولا يتعلق الأمر باعتباره زعيما شعبويا ضد النواب الذين يتهمهم بالفساد.
ولفت هيرست الانتباه إلى أنه في عام 2019، عندما كان سعيّد مرشحا رئاسيا ويتحدث عن الفساد، أجرى مقابلة تحدث فيها بصراحة عن خططه. وعندما طُلب منه وصف برنامجه الانتخابي، أجاب سعيد “لقد اقترحت مشروعا لسنوات لنظام جديد… يجب أن يكون هناك فكر سياسي جديد ونص دستوري جديد”.
وأضاف سعيّد -في تلك المقابلة- أنه في حال فوزه بالرئاسة سيتخلص من الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن “الديمقراطية البرلمانية في الدول الغربية مفلسة ووقتها انتهى.. انظروا إلى ما يجري في فرنسا مع السترات الصفراء وفي الجزائر والسودان، الأحزاب مقدر لها أن تنقرض. انتهى عصرهم.. قد يستغرق موتهم بعض الوقت، لكن بالتأكيد في غضون سنوات قليلة، سينتهي دورهم. سوف تنقرض التعددية من تلقاء نفسها.. لقد دخلنا حقبة جديدة في التاريخ. هذه هي الثورة الجديدة”.
ثم سأله الصحافي المحاور “هل المشكلة مع الأحزاب أم مع التونسيين الذين لا يقرأون؟” ورد سعيد عليه بقوله “المشكلة هي الأحزاب. لقد انتهى دورهم”.
كما أعرب عن نيته الواضحة في التضييق على منظمات المجتمع المدني في تونس، مشيرا إلى أنه لديه “مشروعا يهدف إلى إنهاء الدعم لجميع الجمعيات، سواء من داخل تونس أو من الخارج لأنها تستخدم كوسيلة للتدخل في شؤوننا”.
وختم هيرست مقاله بالقول إذا كان سعيد لا يستمع، فإن المزيد والمزيد من التونسيين من حوله، سيتضررون من أسلوبه في الحكم. فهذه ليست مجرد معركة ضد رئيس شمولي أو برلمان يهيمن عليه الإسلاميون، فقد أصبح التونسيون حاليا يتساءلون إلى أين يقودهم سعيد تونس.
وكان موقع “ميدل إيست آي” كشف في مايو/ أيار الماضي عن خطة لقيس سعيّد للقيام بـ”انقلاب ناعم” في تونس.
———————-
كيف نفهم المشهد في تونس؟
بعد احتجاجات شهدتها تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز عن «تدابير استثنائية» شملت تجميد عمل مجلس النواب مدّة ثلاثين يومًا ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. موقع حبر تواصل في هذا الملف مع باحثين وكتّاب تونسيين ومختصّين بالشأن التونسي، لمساعدتنا على فهم المشهد في تونس بشكل أفضل.
بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن «تدابير استثنائية» تشمل تجميد عمل مجلس النواب مدّة ثلاثين يومًا ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه ليتولى سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس جديد من تعيينه، ما زال الترقّب يسود والجدل يحتدم حول ما إذا كان هذا انقلابًا يشبه ما حصل في مصر عام 2013، أو مسارًا تصحيحيًا لحل أزمة متفاقمة في البلاد.
إعلان سعيد مساء الأحد 25 تمّوز 2021 جاء أثناء اجتماعه مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية، وقال إنه يأتي تفعيلًا للمادّة 80 من الدستور التونسي، التي تتيح للرئيس «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب».
وكان تونسيّون قد خرجوا في مظاهرات صباح الأحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، احتجاجًا على تردّي الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد، قابلتها قوّات الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وفور إعلان سعيّد، خرج آلاف التونسيون للشوارع احتفالًا وترحيبًا بالقرارات، بينما دعا رئيس مجلس النوّاب وزعيم حزب النهضة التونسية راشد الغنّوشي التونسيين للتظاهر أمام مجلس النوّاب – الذي منعته قوّات الجيش من دخوله – لرفض ما وصفه الحزب بـ«انقلاب على الثورة».
وأثار استناد سعيّد للمادة 80 من الدستور جدلًا واسعًا، ووصف البعض إجراءاته بالخروج عن الدستور والانقلاب عليه، حيث أن المادّة تنص على بقاء مجلس النوّاب منعقدًا ولا تتيح تجميده، كما أنها تشترط إعلام رئيس المحكمة الدستورية، وهي التي تعطّلت المصادقة على مشروع قانونها بعد تعطيل استمر سنوات وصولًا إلى خلاف بين الرئيس والبرلمان في الأشهر الأخيرة حول دستورية بعض بنود المشروع.
تباينت مواقف الأحزاب السياسية التونسية، ما بين تأييد لقرارات الرئيس، ورفض لها خوفًا من العودة لنظام الحكم الفردي المطلق، ومواقف أكثر حذرًا لم تدن القرارات لكنها طالبت بضمانات وخارطة طريق. بينما كان موقف الجمعيات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني أكثر تناغمًا، عبرت عن تمسّكها بالمكاسب القانونية والحقوقية للثورة، دون التصريح برفض مبادرة الرّئيس أو دعمها.
حتى نفهم المشهد في تونس بشكل أفضل، تواصلنا مع باحثين وكتّاب تونسيين أو مختصّين بالشأن التونسي. يوضّح الباحث والصحفي فاضل علي رضا لماذا احتفى العديد من التونسيين بقرارات قيس سعيّد، وما هو السياق الذي أتت فيه، بينما تصف الباحثة هالة اليوسفي المشهد وتسلّط الضوء أكثر على مواقف الحراكات الاجتماعية، تحديدًا الاتحاد العام التونسي للشغل، وتناقش الدور المتوقع منها في هذه المرحلة.
أما الباحث والكاتب علي كنيس، فيشرح التخوفات التي تخلقها عسكرة إدارة الشأن العام والتهليل لقرارات الرئيس التونسي الأخيرة، رغم السخط الشعبي إزاء حكومة النهضة. فيما يسرد يوسف الشادلي عن كيف تأزم الشارع في تونس مُنذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات سنة 2019 وصولًا إلى احتجاجات 25 تموز.
———————————-
مسار الانقلاب على الثورة لم يبدأ اليوم، و«الرئيس المنقذ» لن يعكسه/ علي كنيس
في الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية التونسية، يعلن رئيس الجمهورية في اجتماع مع القيادات العسكرية والامنية تجميد أعمال البرلمان وتولي رئاسة النيابة العمومية القضائية. يتحدث الرئيس والجيش والقيادات الأمنية على يمينه ويساره، ينادي باحترام الدستور ويحتكر تأويله في نفس اللحظة، مستفيدًا من عشر سنوات من الخيبات، تتحمل فيها أحزاب مسار الغنيمة المسؤولية بعد سطوها على ثورة الهوامش.
في هذه اللحظة، يقود رئيس الجمهورية انقلابًا يقول إنه يعتمد فيه على الدستور. لكن المعركة ليست على النصّ الدستوري إنما عبر نصّ الدستور، وصاحب القوة الميدانية هو الأقدر على الحسم لصالحه. منذ مدة، وقيس سعيد يغازل الجيش ويطلب ود وزارة الداخلية، عندما أصر على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، العسكرية والمدنية. وفي المقابل، يقود رئيس مجلس النواب جماهيره التي استنزفها منذ عشر سنوات دون أي منجزات نحو مواجهة سلاحه فيها حملة إعلامية خطابية، فيما الجماهير المساندة لقيس سعيد في الشارع تقدم له ما يشبه التفويض قبل حتى أن يطلبه.
لم يكن قيس سعيّد شخصًا يسهُل احتواؤه، خلافًا لما توقعت حركة النهضة وهي التي تحالفت مع الرئيس السابق الراحل الباجي قايد السبسي، الذي قاد بصحبة راشد الغنوشي -رئيس حركة النهضة- ما عُرف بـ«توافق الشيخين»، الذي اعتبرته حركة النهضة توافقًا خدم مصلحة البلاد، فيما رآه كثيرون توافقًا على حساب الثورة، باعتباره أعاد تدوير القديم في الحياة السياسية، وأنتج نفس الممارسات السياسية لنظام بن علي.
تمادت حركة النهضة في نسج تحالفات لم تدم طويلًا، وورّطها ارتباطها بمنظومة الحكم القديمة التي تزداد تشظيًّا في تعقيدات سياسية سببت سخطًا شعبيًّا عليها، ولم تشفع لها سنوات معارضة الاستبداد، خاصة عندما أصبح جليًّا للتونسيين انخراطها في تبييض الفساد المالي والإداري ودفاعها عن الخيارات السياسية لمنظومة الحكم التي أصبحت جزءًا منها. وشهدت الحركة محاولاتٍ للعصيان من مجموعة من قيادات الصف الأول فيها، لكن هيمنة شيخ الحركة راشد الغنوشي على مفاصلها أضعف قدرة هؤلاء على إحداث تغيير في التحالفات والتوجهات السياسية للحركة.
يحاول سعيد إعادة إنتاج لحظة زعامة فردية في مواجهة الانتقال الديمقراطي الذي أدى لاستبعاد مصالح المهمشين من السياسة. لكنه يفعل ذلك على حساب المهمشين أنفسهم.
أما قيس سعيّد، فقد مثّل منذ صعوده لرئاسة الدولة إمكانية لتشكّل بديل سياسي خارج الامتيازات المادية والرمزية القديمة. لكن الإشكالية في البديل الذي يقترحه سعيّد، والقائم على إعادة بناء السلطة السياسية من تحت وتفكيك مركزيتها، تكمن في أنه يحمل إمكانية إعادة إنتاج الصراعات والتناقضات الاجتماعية والاقتصادية التي نراها على المستوى المركزي منذ عقود. فالمجتمع يشهد على المستوى المحلي صراعات بين أصحاب مصالح متناقضة، وتبقى إمكانيات الأقوى ماديًا في فرض خياراته عبر العملية الديمقراطية أعلى من غيره. كما أن الخطاب الذي يقدمه بشعار «الشعب يريد»، والحديث عن مؤامرات يعرفها الشعب بأسلوب عمومي غامض تحت عنوان مصلحة البلاد، يجعله يتغافل عن مراجعة السياسات التي أنتجتها التحالفات الاجتماعية والاقتصادية القديمة التي أتت ثورة 17 ديسمبر للإطاحة بها.
وبعد أن جمع كل السلطات في يده، يتجه سعيّد الآن لتسليم عدد من الملفات للجيش بحجة أن النخبة السياسية والإدارية فشلت في إدارتها. يرافق ذلك حالة من الإنكار الواسعة لوجود انقلاب في البلاد، والتهليل لكل خطوة يتخذها سعيّد. هذه بداية لعسكرة إدارة الشأن العام، ولن يكون التخلص من هذه الإجراءات الاستثنائية سهلًا أبدًا.
يحاول قيس سعيد إعادة إنتاج لحظة زعامة فردية في مواجهة الانتقال الديمقراطي الذي أدى لاستبعاد مصالح المهمشين من السياسة. لكنه يفعل ذلك على حساب المهمشين أنفسهم بأن ينصب نفسه العارف بما يريدون، ويحرمهم بذلك من ممارسة السياسة والدفاع عن مصالحهم الطبقية والسياسية، لمدة ثلاثين يومًا لا ندري إن كانت ستمتد لسنوات.
السياسة ليست اصطفافًا فحسب. إنها أمر يتطلب النقاش والتفكير، دون انتقاص من مشروعية الغضب أو الفرح. والعطش الجماعي لزعيم مخلّص من ديمقراطية فاسدة تقودها حركة النهضة لا يمكن أن يؤدي إلى تغافل أن هذا الوله المفاجئ بالرئيس المنقذ هو هروب من الأزمة الحقيقية، وهي فشل كل النخبة السياسية في الاستجابة لضرورات ثورة 17 ديسمبر، وقيام مشهد سياسي أزاح الثورة من السياسة وزحفت فيه الثورة المضادة منذ عشرة سنوات. أما التذرع بالكذبة الرائجة المسماة «الاستثناء التونسي»، وتعطيل التفكير وتخوين الآخرين واتهامهم بالاصطفاف مع حركة النهضة، إضافة الى التهليل لأي خطوة يتخذها رئيس السلطات الثلاث وصاحب القوة المطلقة، كل هذا يمهد للاستبداد ويطلبه.
—————————
الحركات الاجتماعية ومسارات التحول الممكن في تونس
هالة اليوسفي
هذا الحوار هو نسخة منقحة ومكثفة من حوار أجرته حبر مع الباحثة هالة اليوسفي.
قبل الحديث عن الخطوة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وعمّا إذا كانت انقلابًا بحسب البعض أو تعسّفًا على الدستور بحسب البعض الآخر، من المهم أن نشخّص الوضع العام في تونس. قبل 25 تموز 2021 كان المشهد في تونس كارثيًا؛ وضع وبائي خطير جدًا حتى أصبحت تونس أعلى بلد عربي بعدد الإصابات والوفيات نسبة إلى عدد السكان، أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة جدًا، وأزمة ثقة كبيرة جدًا بين الشعب التونسي والمؤسسات، وأولها البرلمان التونسي، الذي قدّم عرضًا تهريجيًا لبرلمانيين مموِّلين لأقطاب الفساد وأعمال المافيا الموجودين في تونس. هذا أدّى إلى انعدام ثقة كامل في الطبقة السياسية الموجودة في البرلمان وعلى رأسها حزب النهضة – الذي طبّع مع الفساد وطبّع مع النظام السابق – وأزمة ثقة في الأحزاب المعارضة وقدرتها على تشكيل بديل سياسي واقعي للتراجيديا التي كنا فيها. وفي هذه الأثناء، لا يجد المواطن التونسي أكسجينًا يتنفسه.
الرئيس قيس سعيد ليس جزءًا من هذه الطبقة السياسية، هو أستاذ قانون مختص بالقانون الدستوري، لجأت إليه الحركات الاجتماعية أثناء النقاش الوطني التونسي حول المجلس التأسيسي والبدائل التأسيسية والدستورية. وهو دخيل من خارج الطبقة السياسية والاقتصادية الحاكمة في البلاد.
وصل قيس سعيد إلى سدّة الرئاسة في انتخابات 2019 بأغلبية مطلقة وصلت 72 بالمئة من الأصوات. وهو حتى في أوج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كان من الشخصيات الأكثر شعبية في تونس، وكان الناس الذين صوّتوا له يقولون «نحن انتخبناك وها أنت لا تفعل شيئًا بأحد»، أولئك شعروا أن قيس سعيد الذي بنوا عليه الآمال لم يفعل شيئًا أمام تفشي وباء الفساد ووباء كورونا. هذا لربما دفع به للقيام بتأويل واسع للفصل 80 من الدستور التونسي. هل ما فعله انقلاب أم تأويل شاسع للدستور؟ في رأيي هذه مسألة ثانوية لأنه سبق وأن تم تجاوز الدستور عدّة مرّات من قبل حزب النهضة، والمحكمة الدستورية تعطّل تأسيسها بسبب حزب النهضة (الذي يمتلك أغلبية المقاعد في البرلمان الذي عطّل المصادقة على قانون المحكمة الدستورية لسنوات، قبل أن يثار جدل لم يحسم حول دستورية المشروع الذي وضع أخيرًا أمام الرئيس).
شعبيًا، هناك فئة تساند قيس سعيد مساندة مطلقة وتطالبه بالكثير من ناحية تنظيف المناخ السياسي والاقتصادي، ومحاسبة السارقين. وهناك فئة أخرى خائفة. أما في أوساط النخب السياسية والمدنية هناك من يعتبر الوضع انقلابًا وخطرًا على الديمقراطية، بينما غالبية المنظمات الوطنية والحراكات الاجتماعية ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية حقوق الإنسان، وهيئة المحامين (وجميعها لعبت دورًا كبيرًا في الثورة التونسية) أيّدت إجراءات قيس سعيد تأييدًا مشروطًا بضمانات ألا تتواصل هذه الحالة الاستثنائية، لأن تواصلها يعني التحول لحكم استبدادي.
تاريخيًا لم تكن مواقف الاتحاد التونسي العام للشغل مواقف أيديولوجية أو متحيّزة لطرف سياسي معين، لكنها دائمًا تكون نتيجة التفاعلات بين موازين القوى في وسط الاتحاد. قبل أسابيع قليلة كان الأمين العام للاتحاد يهاجم قيس سعيد وينتقده. لكن تقييم الاتحاد هو أن الوضع كارثي وأن السيناريو الوحيد [في ظل استمرار الوضع] كان أن نخسر البلد، لذلك قدّم الاتحاد المصلحة الوطنية واختار التأييد المشروط. نحن في حالة يملك فيها قيس سعيد اليوم كل السلطات: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية وسلطة القضاء، لهذا تتخوف المنظمات الوطنية من أن تدوم هذه الحالة على المدى الطويل، ومن هنا جاء التأييد مشروطًا بضمانات. لم يوضّح الاتحاد ما نوع الضمانات التي يطالب الرئيس بها، ولكنها مرتبطة بخارطة الطريق التي سيقدّمها قيس سعيّد، ونحن الآن بانتظارها.
يطلب النقابيون والتونسيون من الاتحاد اليوم أن يلعب دورًا رقابيًا، وهو ما قاله في بيانه، كما يقع عليه دور تقديم مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لأن الأزمة السياسية موجودة داخل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة جدًا.
الاستثناء التونسي [بين الدول العربية] كان استثناءًا شكليًا: كان لدينا ديمقراطية وانتخابات، لكن المال والفساد المالي شوّه المسار الديمقراطي.
لا يوجد ضمانات على ألا ينقلب قيس سعيد على المسار الديمقراطي ويستلم كل السلطات، لكن لا يزال هناك مسار ثوري في تونس. المشكلة ليست مشكلة ديمقراطية أو مؤسسات ديمقراطية. الاستثناء التونسي [بين الدول العربية] كان استثناءًا شكليًا: كان لدينا ديمقراطية وانتخابات، لكن المال والفساد المالي شوّه المسار الديمقراطي. الحركات الاجتماعية لا تتحدث عن المسار الديمقراطي بل عن المسار الثوري ومطالب الثورة، وهي «شغل، حرية، كرامة وطنية». من الصعب التكهن في الوقت الراهن بالمسار الذي سيأخده سعيد، لكن المهم هو أن القوى والحراكات الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني متأهبة أشد التأهب لأن تقول لا لأي محاولة للاستبداد.
ما سيحدث سيكون نتاج تفاعل بين ثلاثة معطيات، أولًا، خارطة الطريق والإجراءات الاستثنائية التي سيقوم بها الرئيس، وثانيًا، كيفية تفاعل أقطاب النفوذ السياسي والمالي والإقليمي مع هذه الإجراءات، وثالثًا، هل ستتمكّن الحراكات الاجتماعية والمؤسسات الوطنية في تونس من التصدي لمحاولات أقطاب النفوذ والفساد المقاومة لحماية مصالحها من ناحية، ومقاومة أي محاولات استبداد من طرف الرئيس من ناحية أخرى؟ أي أن ما سيحدث لن يكون نتاج قرارات قيس سعيد فحسب، فأصحاب النفوذ والفساد المالي في تونس مهددون، وهناك بالطبع تداعيات إقليمية، لكن هناك كذلك مجتمع مدني سوف يتفاعل مع كل القرارات بطريقة تضمن تصحيح المسار، وتضمن المكتسبات العامة وهي مكتسبات حريات وحقوق، وتسعى كذلك إلى مكتسبات أخرى وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم توفرها النخبة السياسية التي خرجت من صناديق الاقتراع.
الفترة حرجة جدًا والأولوية هي أن يحد قيس سعيد من الكارثة التي تعيشها البلاد، وأن يحاول الحد من نفوذ أصحاب الأموال. ولكن هل سيتمكن من اقتراح بديل اقتصادي واجتماعي كامل؟ هذا ليس شأنه وحده فقط، بل شأن كل القوى الاجتماعية والديمقراطية في تونس. أقصى ما يستطيع سعيد أن يقوم به هو دعم محاولة تصحيح المسار الثوري، بطريقة تمكننا على المدى الطويل أن نحاول تبديل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية برمتها، ولكن هذا سيكون عملًا شاقًا وصعبًا وطويل الأمد. على المدى القصير، السيناريو الأفضل هو الحد من التراجيديا التي نعيشها ومن استنزاف الشعب التونسي من النخبة السياسية الفاسدة. لا أحد في تونس يطالب قيس سعيد أن يكون المنقذ لوحده ولا ننتظر منه ذلك.
—————————-
الجذور الاقتصادية والصحية للدعم الشعبي لقرارات سعيد/ فاضل علي رضا
ترجمة ريما هديب
قوبل إعلان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، باحتفالات في جميع أنحاء تونس على الفور، حيث خرق الآلاف حظر التجول ليغنوا ويهتفوا، ويطلقوا الأبواق والألعاب النارية. أثارت خطوة سعيد انتقادات من قبل خصومه السياسيين، والتي عبر عنها بصراحة حزب النهضة، الحزب الأكثر خسارة للسلطة، حيث ندد بالخطوة باعتبارها «انقلابًا». لكن الأمر يستحق تنحية الأسئلة القانونية جانبًا للحظة، لمحاولة فهم سبب احتفال شرائح كبيرة من المجتمع التونسي بهذه المستجدات.
إن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في 25 تموز، رغم الحرارة الشديدة، في جميع أنحاء البلاد، يضمون بينهم أولئك الذين أرادوا ثورة جديدة، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين أرادوا أن يتولى قيس سعيد السلطة فيما وصفه البعض بأنه انقلاب وليس ثورة. لكن المظالم الرئيسية لهؤلاء المتظاهرين هي نفسها، وكانت نفسها بين مختلف الحركات الاحتجاجية والمظاهرات في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه المظالم عنف الشرطة الذي يصل حدّ القتل، والقمع، وانعدام المساواة الاقتصادية، والأوضاع المتدهورة بشكل عام في جوانب البطالة والأجور وأسعار السلع الاستهلاكية، وسياسات الدولة غير العادلة في الزراعة والمياه والقضايا البيئية، وإفلات المسؤولين من العقاب، وتجاهل أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح على يد القوات الحكومية خلال الثورة، ومؤخرًا تدهور الأوضاع في الخدمات الصحية، والاستجابة غير الملائمة وغير المنظمة وغير الفعالة لكوفيد-19. تأتي هذه القضايا العامة الملحة التي تجاهلتها الحكومات التونسية المتعاقبة، لتتوج سنوات من النقص العام في الاستثمار، وتدهور الخدمات العامة في التعليم والنقل أيضًا.
لكن يبدو أن الأزمة الصحية كانت أحدث محفّز لغضب ومعارضة واسعة النطاق ضد قوى السلطة. شهدت تونس واحدة من أسوأ معدلات الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 نسبة إلى عدد السكان في العالم في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك لم يبدُ أن المسؤولين الحكوميين يتعاملون مع الأزمة بالإلحاح المطلوب. في عطلة نهاية الأسبوع بتاريخ 17 و18 تموز، نشرت منظمة «أنا يقظ» (IWatch)، وهي منظمة رقابية تونسية لمكافحة الفساد، صورًا لرئيس الحكومة هشام المشيشي وفريقه وهم يسترخون بجانب حمام سباحة في فندق فخم في مدينة ساحلية. أثارت هذه الصور تساؤلات حول استخدام محتمل للأموال العامة، ولكن الأهم من ذلك أن هذه الصور بدت منفصلة ومعزولة عن الظروف الخطيرة في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد. إذ انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأطباء وهم يبكون بسبب افتقارهم إلى المعدات والكوادر اللازمة لعلاج مرضاهم.
وبينما كان وزراء الحكومة يسترخون في أحد الفنادق، كان معظم التونسيين عالقون في أحيائهم بموجب حظر تجول في نهاية الأسبوع، يمنع التنقل دون تصريح في جميع أنحاء العاصمة تونس وبين المدن التونسية. كانت عمليات الإغلاق وحظر التجول عقابية للمواطنين التونسيين، ومدمرة للشركات التي تفتقر إلى العلاقات أو الموارد للحصول على تصاريح الإعفاء من حظر التجول. وتركت الإغلاقات العديد ممن فقدوا وظائفهم بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي يائسين، مع مساعدات حكومية شحيحة تقدّم لهم، أو لا تقدّم على الإطلاق. في الوقت نفسه، لم تُبرهن الحكومة على فعالية هذه الإجراءات العقابية في إبطاء انتشار الوباء على أرض الواقع.
لكن الألم الاقتصادي يتجاوز مجرد الاستجابة لأزمة كوفيد-19، في أيار وحزيران رفعت الحكومة أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، مثل مياه الشرب والسكر. لمّح البعض إلى أن هذه الزيادات في الأسعار قد تمت لإرضاء صندوق النقد الدولي، الذي كانت تونس تجري معه مفاوضات للحصول على قرض جديد منذ أيار 2021. جاء برنامج قرض صندوق النقد الدولي لتونس، والممتد من 2013 إلى 2020، مع شروط لتجميد التوظيف في القطاع العام -بما في ذلك في قطاع الصحة-، وهو ما كان له العديد من الانعكاسات الاجتماعية السلبية، دون أن يساهم في تحسين البطالة أو العجز التجاري.
في حين أن كل ما سبق يساعد في تفسير سبب ترحيب الجماهير في الشوارع بقرارات قيس سعيد في 25 تموز، هناك بالفعل الكثير ممن يشعرون بالقلق من أن قراراته هذه لن تكون قادرةً على حل جميع مشاكل تونس. إلى جانب حزب النهضة، أعربت أكبر الأحزاب السياسية المنتمية للائتلاف الحاكم عن إدانتها لما اعتبرته تركيزًا غير دستوري للسلطة في يد شخص واحد، مع تعبير أقلية فقط من الأحزاب عن دعمها لرئيس الجمهورية. تحاول بعض المؤسسات بالفعل تأكيد استقلالها، إذ أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا أشار فيه إلى أن السلطة التنفيذية التي تندرج تحت رئيس الجمهورية لا تملك سلطة العمل كمدعٍ عام، كما نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باقتحام الأجهزة الأمنية مكتب قناة الجزيرة في 26 تموز، و«دعت النقابة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير قانونية وفقًا لما ينص عليه الدستور».
يتمتع رئيس الجمهورية في الوقت الحالي بشعبية واسعة، لكن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العديدة والمعقدة التي يواجهها لا يمكن حلها على الفور. سوف تدق ساعة قدرته على التعامل معها، وساعة إعادته السلطة إلى أجهزة الحكومة الأخرى. إذا أصبح تركيز سلطاته أداة للقمع، فهناك العديد من الحراكات والنقابات والجمعيات والمؤسسات التي مارست حرية التعبير في السنوات العشر الماضية، والتي لن تتنازل بسهولة عن مثل هذا الامتياز الذي جرى الحصول عليه بشق الأنفس. في غضون ذلك كله، واجه المواطنون التونسيون بشجاعة القمع والاضطهاد مرات لا تحصى، وانتصروا. ومن المؤكد أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى، إذا شعروا بالحاجة.
————————–
انقلاب تونس.. لماذا قد تكون أيامه معدودة؟/ ديفيد هيرست
يفقد انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد الزخم. لا يحصد الدعم الأجنبي الذي يحتاجه لإدارة البلاد بمفرده، وتدرك دوائر أوسع وأوسع من التونسيين في الداخل الآن مَن الذين يديرون الدولة والحكومة والقضاء.
من وجهة نظر سعيد، لا عمليات التطهير ولا التعيينات تسير بالسرعة الكافية. اقترح زهير المغزاوي، الأمين العام لـ”حركة الشعب” المؤيِّدة للرئيس، تمديد تعليق سعيد للبرلمان لمدة ستة أشهر.
يُعَدُّ الدعم الأجنبي مهماً لبلدٍ صغيرٍ مُفلِسٍ مثل تونس، الذي لا يستطيع دفع فاتورة أجور القطاع العام الضخمة، ويدين بسداد ديونه الخارجية، التي تبلغ وحدها 6 مليارات دولار هذا العام.
لذلك، فإن ما يعتقده الأجانب من أصحاب المصلحة في الاقتصاد التونسي يمثِّل أمراً ذا أهمية، وهم لا يخبرون سعيد بما يريد أن يسمعه.
أفادت مصادر تونسية وإيطالية أن سفراء ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة طلبوا منه إعادة البرلمان بأسرع ما يمكن. وأخبرتني مصادر تونسية مُطَّلِعة أن الأمريكيين منعوه من تنظيم مسيرة حاشدة لصالح الاستيلاء على السلطة. ولقد نقلوا جميعاً رسائل دعم إلى راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة، بالإضافة إلى قادةٍ حزبيين آخرين.
وفي حين أن الرسائل التي تُسلَّم إلى سعيد هي رسائل خاصة، تصدر رسائل الإدانة العامة في الداخل أيضاً. قال السناتور الأمريكي جيم ريشي، والسناتور بوب مينينديز العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنهما “قلقان للغاية” بشأن التوتُّر المتزايد وعدم الاستقرار في تونس. وأضافا: “يجب على الرئيس سعيد إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقات الأمريكية-التونسية، ويجب على الجيش مراقبة دوره في ديمقراطيةٍ دستورية”.
قد يميل سعيد إلى تجاهل كلِّ هذا؛ إذ يعتقد الآن أن لديه تأكيداتٍ من الإماراتيين والسعوديين بأنهم سيموِّلونه. لكن قبل قبول هذه الوعود المالية الخليجية باعتبارها حقيقية بالفعل، عليه أن يسأل السودانيين عن تجربتهم.
عندما أُطيحَ بعمر البشير من الرئاسة في أبريل/نيسان 2019، وعدت المملكة السعودية والإمارات بتقديم 3 مليارات دولار في صورة مساعدات للسودان. سُلِّمَت 750 مليون دولار فقط من تلك المساعدات، ولم يُسلَّم أيُّ شيءٍ آخر منذ إبرام تقاسم السلطة مع الجيش في العام 2019. والآن قدَّم السعوديون وعداً آخر لاستثمار 3 مليارات دولار في صندوقٍ مشترك في السودان، مع “إعادة الالتزام” بقرض 2019، الذي لم يصل منه إلا 300 مليون دولار أخرى.
الوعد يختلف عن التسليم، وفي غضون ذلك يرتفع التضخُّم في السودان بنسبة 400%.
نهج الجزائر
الحكومة الجزائرية هي التي يجب أن تقلق أكثر بشأن سعيد. تونس بلدٌ صغير لديه جيران كبار. وهؤلاء الجيران لا يتضمَّنون مصر ولا الإمارات، اللتين نظَّمتا ودعمتا هذا الانقلاب، على التوالي.
بدأت الجزائر بنهجٍ رقيقٍ وهادئ. سافر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى تونس لإيصال “رسالة شفهية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون”، لكن لم يُعلَن محتوى الرسالة. وسافر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أصدرت الرئاسة المصرية البيان التالي: “تم التوصُّل إلى توافق على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد وكل ما مِن شأنه الحفاظ على الاستقرار في تونس وتنفيذ إرادة وخيارات الشعب التونسي الشقيق، حفاظاً على مقدرات وأمن وطنه”.
ولم يصدِر الجانب الجزائري أيَّ تصريحٍ مماثل.
وحين اتَّضَحَ أن رسالتهم لم يُلتَفَت إليها، كان المسؤول الجزائري التالي الذي تحدَّثَ هو رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، الذي قال إن “المؤامرات والمكائد التي تُحاك ضد الجزائر وشعبها ليست من نسج الخيال كما يدَّعي من يشكِّكون، لكنها حقيقة واقعة ويراها الجميع”.
وقبل أيامٍ قليلة، سحبت الجزائر ترخيص قناة العربية، المملوكة للمملكة السعودية، للعمل في الجزائر، مُتَّهِمةً القناة بـ”نشر معلوماتٍ مُضلِّلة”. وكان الفريق شنقريحة يوجِّه تحذيراً واضحاً للسعودية والإمارات ومصر بالتراجع.
العواقب الدولية
تعتبر الجزائر تونس بمثابة ساحتها الخلفية وبوابتها إلى طرابلس، ولها مصلحة إقليمية واضحة في الأحداث في كلٍّ من تونس وليبيا. حاولت مصر والإمارات وروسيا فرض الجنرال المنشق من عهد القذافي، اللواء خليفة حفتر، على ليبيا، وأصبحت قوات حفتر على بُعدِ بضعة كيلومترات من وسط مدينة طرابلس، قبل أن تتراجع تحت ضغط الطائرات التركية المُسيَّرة؛ ونتيجة لذلك، فشل حفتر، وشُكِّلَت إدارةٌ مؤقَّتة بدعمٍ من الشرق والغرب.
وفي أعقاب الفشل في ليبيا، يحاول الإماراتيون الآن إنجاز بعض الغايات في تونس، أو على الأقل هذا ما يراه الجزائريون، وقد يكونون على حق.
قال مصدرٌ جزائريٌّ رفيع المستوى لموقع Middle East Eye: “ليس أمام هذا الانقلاب أفقٌ للنجاح. طالبنا بأن يتفاوض قيس مع الغنوشي، ونحن نعلم بالضبط كيف أنفَذَ المصريون والإماراتيون هذا الانقلاب، لا نريد أن نرى حفتر جديداً في تونس، ولا نريد أن نشهد حكومةً خاضعةً لهذه القوى”. كان هذا واضحاً وحاداً للغاية.
يشعر الإيطاليون أيضاً بالقلق بشأن ليبيا. قال رئيس الوزراء السابق رومانو برودي إن ما يجري في تونس ليس قضيةً داخلية: “إن عواقب التحوُّل إلى الاستبداد سوف تتجاوز حدود تونس. نحن، الأوروبيين، نفقد التأثير السياسي على الضفة الجنوبية من البحر المتوسط”.
وقال إن كلَّ ذلك يؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على إيطاليا، ليس فقط من حيث الخطر المتزايد لجائحة كوفيد-19، بل أيضاً من خلال الموجات المُتوقَّعة من المهاجرين.
وتقلق الحكومة التركية أيضاً بشأن الأحداث في تونس، وليس أقل أسباب هذا القلق هو الشعور بأن الانفراج الأخير من جانب مصر والإمارات إزاء أنقرة قد يكون حيلةً لإثناء تركيا عن التدخُّل المباشر، الذي يتمثَّل في خطوةٍ ضد تونس.
كان استعراض تركيا القوة في ليبيا أمراً حاسماً. إنها لم توقف حفتر فحسب، بل أيضاً خطط كلِّ القوى التي تقف وراءه: الروس، والإماراتيين، والإسرائيليين، والفرنسيين، الذين دعموه عسكرياً في مرحلةٍ أو أخرى. لكن هل كان لتركيا أن ترفع عينيها عن تونس في خطتها لمواصلة الضغط على طرابلس؟
“لا يُصغي”
أما في تونس، فإن سعيد لا يصغي إلى أيٍّ من ذلك. يحك الدبلوماسيون الإيطاليون رؤوسهم، وهم يشكون من أنه لا يفهم أن الديمقراطية بطبيعتها تعدُّدية، ولا يتعلَّق الأمر على الإطلاق بزعيمٍ شعبوي ضد النواب الذين يتَّهمهم بالفساد.
في عام 2019، عندما كان سعيد مُرشَّحاً رئاسياً يتحدَّث عن الفساد، أجرى مقابلةً تحدَّثَ فيها بصراحةٍ عن خططه. وحين طُلِبَ منه وصف برنامجه الانتخابي، أجاب قائلاً: “لقد اقترحت مشروعاً لمؤسسةٍ جديدة.. يجب أن يكون هناك فكرٌ سياسي جديد ونصٌّ دستوري جديد”.
وأضاف أنه في حال فوزه بالرئاسة سيتخلَّص من الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن “الديمقراطية البرلمانية في الدول الغربية مُفلِسة، ووقتها انتهى.. انظروا إلى ما يجري في فرنسا مع السترات الصفراء، وفي الجزائر، وفي السودان. الأحزاب مُقدَّر لها أن تفنى. انتهى عصره.. قد يستغرق موتهم بعض الوقت، لكن بالتأكيد في غضون سنواتٍ قليلة سينتهي دورهم. سوف تنقرض التعدُّدية من تلقاء نفسها.. لقد دخلنا حقبةً جديدةً في التاريخ. هذه هي الثورة الجديدة”.
ثم سأله المُحاوِر: “هل المشكلة مع الأحزاب أم مع التونسيين الأميين؟”، فردَّ سعيد: “المشكلة هي الأحزاب. لقد انتهى دورهم”.
وأعرب سعيد عن نيته الواضحة في التضييق على منظمات المجتمع المدني في تونس، مضيفاً: “لديّ مشروعٌ يهدف إلى إنهاء الدعم لجميع المجتمعات، سواء داخل تونس أو خارجها، لأنهم يُستخدَمون كوسيلةٍ للتدخُّل في شؤوننا”.
هذا ليس بياناً ولا خطةً اقتصادية. كان ردُّ فعل سعيد على العداء الذي واجهه من إدارة بايدن هو إقالة سفير الولايات المتحدة، وهو الرجل الذي رشَّحه بنفسه قبل عامٍ واحدٍ فقط. ويتلخَّص برنامجه الاقتصادي في جعل الأثرياء يدفعون المال للأحياء الفقيرة. هذه ليست خطة، والفكرة نفسها ليست جديدة. وفكرته عن السياسة النقدية هي دعوة البنوك لخفض أسعار الفائدة. ولكي نكون صادقين، هذه ليست دعوة يقوم بها الرئيس، بل إنها وظيفة البنك المركزي. وكما رأينا في تركيا، هذه ليست سياسةً تثير إعجاب الأسواق.
سببٌ للإنذار
يجب أن يُقال أيضاً إن مصر، أقرب حليف لسعيد، ليست مثالاً جيداً. إنها اليوم أفقر وأضعف بما لا يُقاس مِمَّا كانت عليه عندما تولَّى السيسي السلطة في انقلابٍ عسكري في 2013. في اليوم نفسه الذي التقى فيه وزير الخارجية المصري بسعيد لمنحه الدعم الكامل، أعلن السيسي خططاً لخفض الدعم الحكومي للخبز- كانت تجربة ذلك للمرة الأولى في عهد السادات عندما أثار احتجاجاتٍ غاضبة.
تتجسَّد المفارقة في كون مصر نموذجاً لتونس تتبعه حالياً في الإحصاء الذي يفيد بأن معدَّل الفقر في مصر أعلى بكثيرٍ من تونس -31% مقابل 19% في عام 2020.
إذا كان سعيد لا يصغي، فإن المزيد والمزيد من التونسيين حوله بدأ يؤثِّر عليهم عدم استقرار أسلوبه في حكم الفرد الواحد.
وضعت قواته نقابة المحامين التونسيين تحت الحصار أثناء سعيها للقبض على أحد المحامين. ومِمَّا يُحسَب لهم أن المحامين صمدوا ورفضوا تسليم مهدي زغروبة للاعتقال. وكانت النتيجة أن تراجَعَ القضاء العسكري وأسقط الدعوى ضد زغروبة وأربعة نواب آخرين، جميعهم أعضاء في ائتلاف الكرامة في البرلمان.
هذه ليست مجرد معركة ضد رئيسٍ شمولي أو برلمانٍ يهيمن عليه الإسلاميون. ويسأل التونسيون أنفسهم أكثر وأكثر إلى أين يقودهم سعيد.
ليست مخاوف جيرانه حول البحر المتوسط متجذِّرةً في المقام الأول في الجدل بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية. إنهم قلقون على استقرار تونس. والرئيس غير المستقر يقدِّم لهم كلَّ أسباب القلق. وهم لا يصدِّقونه ولا يثقون به ولا يدعمونه. أعتقد أن أيام الانقلاب باتت معدودة.
– هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.
——————————–
=====================
تحديث 08 آب 2021
————————–
الثقافة والغناء وتعبيد الطغيان… مناشدات المثقفين لبناء الديكتاتورية في تونس / كمال الرياحي
من لم يحفظ عبارة الألماني المنتحر جوزيف جوبلز، وزير الدعاية السياسية النازي في عهد هتلر “كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي”. كانت عبارة تشير إلى موقف الديكتاتورية من المثقف الحر، لكن جوبلز لم يتحدث عن حقيقة الدور الآخر الذي تلعبه الثقافة في أزمنة الديكتاتورية عندما تعبد له طريق التمكين.
لم ينتظر المشهد الثقافي والفني في تونس ساعات، بعد ما حصل من أحداث سياسية، ليخرج علينا مناشداً الرئيس، في مشهد ذكرنا بمناشدة المثقفين للدكتاتور زين العابدين بن علي، للترشّح إلى ولاية أخرى غير شرعية قبل الثورة. وانتشرت قائمة الإمضاءات كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن خرجت تحت مسمى بيان “30 شخصية وطنية”، لا ندري من أعطاهم هذه الصفة دون غيرهم. وتحولت هذه القوائم إلى قوائم شعبية: كلٌ يريد أن يلتحق بالوطنية التي يكفي أن تمضي لتصبح ضمنها، ويكفي أن تمتنع عن الإمضاء لتكون خارجها.
لم يعط المثقف التونسي فرصة لنفسه حتى الفرصة التي أعطاها الرئيس لنفسه ليفهم نفسه ويناشد نفسه أو يتراجع، وهي فترة ثلاثين يوماً، بل إن الرئيس قال إنها اجراءات وقتية واستثنائية، تنتهي بانتهاء أسبابها وربطها بالخطر الداهم، بينما تسابق المثقفين في تونس إلى تحويلها إلى أبدية والمطالبة بخارطة طريق، وكأنهم بذلك يخلعون عليها الشرعية الكاملة. وانطلقت حملات التخوين والعنف في مواقع التواصل الاجتماعي، وإخراج المعارضين أو حتى المتسائلين من الملة الوطنية. وانتشرت ثقافة “الوشاية عمل وطني”، عبر التقاط صور التدوينات المخالفة لما سماه الحقوقي، جوهر بن مبارك، بـ”الفونطازم”.
لطيفة على الخط والخطأ الجسيم
أطلقت بسرعة المغنية المقيمة بمصر، لطيفة العرفاوي، أغنية اعتبرتها وطنية، تقول بعض كلماتها “والي موش عاجبو على برا”. إن حق الاختلاف أو حتى الانحراف النسبي في إبداء التفاعل والانفعال سيبقى مقبولاً لو ظلت الأغنية على حساب المغنية فقط، لكن الخطير أنها نزلت بالتزامن على حساب رئيسة ديوان الرئيس، والتي لم تنشر شيئاً منذ تهنئتها للشعب بعيد الجمهورية تموز/جويلية 2021، تاريخ بداية الأحداث وإعلان القرارات الجديدة، نزول الجيش للشارع وتعليق أعمال البرلمان بعد تفعيل وتأويل الفصل 80.
ظل قسم كبير من الشعب وهو يتابع تصريحات الرئيس قيس سعيد متفائلاً قليلاً بالعودة للمسار الديمقراطي، فهو لم ينفك يؤكد على حماية حرية التعبير والمسار الديمقراطي، وأن الاجراءات الاستثنائية فقط لحماية المؤسسات، إلا أن تبني هذا الخطاب الاقصائي في هذه الأغنية من رئيس الديوان الرئاسي أصاب الناس بالرعب. ماذا يعني “الي موش عاجبو على برا”؟ أليس هذا تهديد للمسار الديمقراطي بالكامل؟
إن التهديد بالنفي والطرد، وربما حتى بالتصفية، فكلمة “على برا” حمالة أوجه، يضع النظام في مأزق، لأنها لم تعد جملة على لسان لطيفة العرفاوي، بل على لسان رئيسة ديوان الرئيس والناطقة باسمه.
قد نرجع ذلك إلى محدودية ثقافتها، ولكن مراجعة صور الرئيس قيس سعيد في مصر، وقرب السيدة المديرة من لطيفة العرفاوي التي في الصور معهم، تطرح سؤالا أخطر: هل تم إنتاج هذه الأغنية بطلب من رئيسة الديوان، لكي تتبناها وتنشرها عندها ولم تشاركها حتى من حساب المطربة؟
أين تكمن الخطورة؟
إن الاحتجاج الكبيرة الذي نقرأه من التوانسة على هذه الأغنية وتوظيفها وما تهدد به المختلفين وأصحاب الآراء الأخرى وتهديدها للحريات، يجعل من الرئاسة مطالبة بتوضيح إذا أرادت أن تواصل في رعايتها لحرية التعبير.
فقد كان الغناء على مدى التاريخ العربي لصيقاً بالدكتاتوريات ويجند لتثبيتها والتغطية على عيوبها، ولا فائدة من التذكير بالذي كانت تفعله أم كلثوم في عهد عبد الناصر، ولا بالذي كان يفعله عبد الحليم وعلية في عهد بورقيبة، ولا داعي للتذكير بالذي كان يحصل في المقابل للأصوات المختلفة للكتاب والفنانين والشعراء كالشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم…
إن تهافت المثقفين والفنانين لتقديم الولاء حوّل الأمر إلى حفلة مبايعة تنذر بخطر كبير يهدد التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى المشهد الثقافي أن يتعقلن، فهذا المثقف الذي كان طوال سنتين يقول إنه لا يفهم شيئاً من خطاب الرئيس، صار بقدر قادر يفهم كل شيء من دون العالم كله، وقف ليخوّن في بعضه على الهوية، ضمن هيستيريا تبريرية لكل الأخطاء الاتصالية التي تحدث. هذا المشهد السوريالي الثقافي في ظل مشهد سياسي متحرك يجعلنا نسمع صوت عبد الله القسيمي ملعلعاً: “أيها العقل من رآك”.
إن تاريخ تصفية المثقفين من السلطة يوازيه تاريخ كامل لانحطاط المثقف وانبطاحه أيضاً، ولم يتحول زين العابدين بن علي وبشار الأسد ومعمر القذافي وحافظ الأسد ومبارك وعلي عبد الله صالح وصدام حسين، واقترابهم من العم كيم جونغ أون، إلا بفضل هؤلاء الذين يعيشون دائماً في “شوق إلى الديكتاتورية” التي كتبنا عنها هنا قبل عام بعنوان: “حبيبنا كيم جونغ أون… عن الشبق الدامي وشوق العرب إلى الديكتاتورية”.
كل ما نتمناه هو التريّث ومراجعة هذا الخطاب الخطير والتصدي له كيلا ننجرف إلى ديكتاتورية أسوأ من سابقاتها.
—————————–
مراسلة «نيويورك تايمز» تُثير القلق بشأن مستقبل الحريات في تونس
لندن ـ «القدس العربي»: أثارت مراسلة جريدة «نيويورك تايمز» فيفيان يي التي التقت الرئيس التونسي قيس سعيد وفوجئت به يلقي على مسامعها محاضرة معدة سلفاً بدون السماح لها بطرح أي سؤال، أثارت موجة من الجدل والقلق بشأن مستقبل الحريات الصحافية في تونس في أعقاب جملة القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد والتي اعتبرها البعض «انقلاباً على المؤسسات الدستورية». ورغم أن المخاوف بشأن مستقبل الحريات الصحافية والإعلامية وحق الناس في إبداء الرأي وممارسة العمل السياسي قد اندلعت فور إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، إلا أن حادثة مراسلة «نيويورك تايمز» زادت من هذه المخاوف وأشعلت قلقاً متزايداً في أوساط الإعلاميين والصحافيين بشكل خاص.
ونشرت المراسلة الصحافية تفاصيل لقائها مع الرئيس التونسي في قصره بعد خمسة أيام فقط على اتخاذه قرار تجميد البرلمان، حيث وصفت عبر تقرير مطول كيف تم استدعاؤها مع اثنين من الصحافيين الأجانب وهم يظنون أنه سيُتاح لهم إجراء مقابلة مع سعيد وطرح الأسئلة عليه، فإذا به يُفاجئهم بإلقاء محاضرة على مسامعهم من دون السماح لهم بطرح أي أسئلة.
وتتحدث فيفيان عبر تقريرها الذي نشرته «نيويورك تايمز» كيف أن قيس سعيَّد بدأ حديثه إليها بأن تعهد بالحفاظ على الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير في تونس، لكنه في الوقت ذاته أجلس الصحافيين، وبدأ يتلو على مسامعهم محاضرة، بدون السماح لهم بطرح أي أسئلة، فضلاً عن «عدم السماح للصحافية بوضع ساقٍ على ساق خلال جلوسها في القصر الرئاسي».
وتقول يي إن «الرئيس قيس سعيد استغل سنوات البطالة المستعصية، والفقر المتزايد، والفساد المنتشر، والمأزق السياسي، إضافة إلى وباء كورونا، وتدفق التونسيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، فوجدها فرصته المناسبة للاستيلاء على السلطة».
وتضيف إنها واثنان من الصحافيين العاملين معها في «نيويورك تايمز» تلقوا اتصالاً من مكتب الرئيس التونسي، وفهموا أنهم ذاهبون لإجراء مقابلة مع الرجل، لكنهم فوجئوا بهم يبدأ محاضرته اليهم بقراءة مواد من الدستور الأمريكي، قال لهم إنه قام بتدريسها لطلبته في الجامعة طيلة ثلاثة عقود.
وتابعت: «عندما بدأ أحد زملائي في الترجمة، أمروه بالتوقف. تم تصوير كل شيء من قبل طاقم تصوير حكومي، وأدركنا أنه سيتم نشر مقطع فيديو للحلقة بأكملها على صفحة الرئيس الرسمية على فيسبوك، وربما كان هذا هو السبب في أنه من المهم أن نكون صامتين.. كنا نحن الجمهور». وتقول يي إنهم عندما بدأوا المحاولة في طرح الأسئلة، قال لهم الرئيس: «هذه ليست مقابلة صحافية».
وأثارت هذه الحادثة قلقاً بشأن مستقبل الحريات الصحافية في تونس، حيث التفت الكثيرون إلى ما حدث معتبرين أنه مؤشر على عدم قبول الرئيس لفكرة المساءلة، ولا قبوله لنشاط الصحافيين وحقهم في الحصول على المعلومات من أجل إيصالها إلى الناس.
وتحدثت «القدس العربي» إلى أحد الصحافيين في تونس والذي أبلغها بأن الإجراءات الأخيرة نشرت موجة من الرعب والذعر في أوساط الإعلاميين، وأضاف: «هذه حالة غير مسبوقة في أوساط العاملين بالصحافة منذ أكثر من عشر سنوات».
وحسب الصحافي فإن «الأحداث الأخيرة أعطت انطباعاً بأن الحريات الصحافية تتجه إلى التراجع، وأعادت إلى الأذهان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان يهيمن على وسائل الاعلام في البلاد».
وكانت «منظمة العفو الدولية» قد دعت الرئيس التونسي إلى «التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وقالت المنظمة في بيان لها: «ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية».
وأضافت أن «المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة».
وتابعت أن «الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد».
القدس العربي
——————————
قيس سعيّد يريد جماهيرية .. ماذا يريد الشعب؟/ عائشة البصري
منذ ولوج الرئيس التونسي، قيس سعيد، قصر قرطاج، وهو يعارض النظام من الداخل، من أعلى هرم السلطة. ساهم في تعطيل عمل الحكومة، رفض أداء الوزراء اليمين، ومنع تأسيس المحكمة الدستورية. لم يخاطب البرلمان ولو مرّة، تبرّأ من الأحزاب براءة الذئب من دم يوسف، وصرخ في وجه المنظومة السياسية في بداية ثورة الياسمين: “ليرحلوا كلهم بمعارضتهم وبأغلبيتهم. ليعلنوا أنهم أفلسوا”. فكيف ينقلب، إذن، الرئيس على المسار الديمقراطي، وهو لم ينخرط فيه بالأساس؟ وكيف ينقلب على الدستور، وقد جاهر برفضه قبل أداء اليمين الدستورية وبعده؟
ما أقدم عليه الرئيس، منذ ليلة 25 يوليو/ تموز الماضي، ما هو إلا بداية تفعيل مشروع “الانتقال الثوري الجديد”، الذي مرّ عليه الإعلام مرور الكرام، وتجاهلته القوى المدنية والسياسية إبّان الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. في حوار أجرته معه كوثر زنطور، ونشرته أسبوعية “الشارع المغاربي”، يوم 11 يونيو/ حزيران 2019، تحدث قيس سعيّد، بأريحية، عن قناعاته الشّعبوية، وقرأ الفاتحة على الأحزاب التونسية التي توقّع اندثارها من تلقاء ذاتها، لأن عهد الأحزاب والديمقراطية النيابية ذاتها قد ولّى. في المقابل، مجّد الشعب ومدح قدراته على مباشرة الحكم من دون وساطة حزبية.
في بضعة سطور، لخّص قيس سعيّد تصوّره لثورة تقوم على إزاحة النظام الحزبي، وتأسيس نظام رئاسي على مستوى القمة، ومجالسي في القاعدة. ينطلق هذا “البناء القاعدي” من المحلي نحو المركزي، بانتخاب مجالس محلية في كل معتمديات تونس الـ 265، ومن كل مجلس محلي يتم اختيار عضوين، الأول يمثله في المجالس الجهوية للولايات الـ 24، والثاني يمثله في مجلس نواب الشعب. حسب هذا التصور، تتمتّع المجالس بالسلطة التشريعية والرقابية، وتضطلع بمهمة بلورة المشاريع التنموية وتنفيذها، بينما ينفرد رئيس الجمهورية بالسّلطة التّنفيذية كاملة، ويتكفّل بتعيين رئيس الحكومة.
في المقابلة ذاتها، تعهد سعيّد بعدم إجراء انتخابات تشريعية مباشِرة في حال انتخابه رئيسا للبلاد، إذ إن مشروعه السياسي يشمل فقط انتخابات محلية ورئاسية، تسبقها “عملية تطهير للبلاد”، شبيهة بالتي يقودها اليوم. ولم يُخفِ أنه يعتزم تعديل دستور 2014 لتحقيق مشروعه السياسي، من دون أن يشرح كيف سيتسنى له ذلك، والفصلان 143 و144 من الدستور ذاته يحظران تغيير نظام الحكم أو تعديل الدستور، إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشّعب ووجود محكمة دستورية. لم يتوقف المرشّح عند المجاهرة برغبته في حذف المنظومة الحزبية، وإنما أقرّ أيضا بأنه ينوي إيقاف دعم كل الجمعيات، إذ يعتبرها مطيّة خارجية للتدخل في شؤون البلاد.
من المؤسف أن الإعلام لم يقم بواجبه تجاه الناخب التونسي، ولم يطرح للنقاش العام مشروع ثورته المضادّة. وحتى عندما واجه منافسه، نبيل القروي، مساء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في مناظرة تلفزيونية حاسمة، تابعها سبعة ملايين مشاهد، لم يطلب الصحافيان منه شرح مشروع إزاحة الديمقراطية النيابية لتأسيس نظام حكم بديل. منعتهما تعليماتُ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، من “الانخراط في محاجّة المترشحين”، وفرضت عليهما التقيّد بأسئلةٍ متفقٍ عليها مسبقا.
لو طُرح للنقاش مشروع ديمقراطية سعيّد المجالسية، لأدرك الناخب أن الأستاذ يريد أن يُجرّب في تونس نسخة منقّحة من جماهيرية الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي. يصعب عدم استحضار أوجه الشبه بين سعيّد الذي يصف الأحزاب “بخيانة المؤتمن” والزعيم القذافي المعروف بشعار: “من تحزّب خان”. كلاهما زعيم شعبوي مثير للجدل والسخرية، كاره لمؤسسات الدولة، رافض للتعدّدية والمعارضة السياسية، مروّج أسطورة حكم الشعب نفسه بنفسه. ويقابل هرم مجالس سعيّد الثلاثة، نظام القذافي المؤسَّس أيضا على ثلاثة مستويات: اللجان/ المؤتمرات الشعبية الأساسية، المؤتمر الشعبي غير الأساسي، والمؤتمر الشعبي العام.
على خطى القذافي، يسير قيس سعيّد بثبات، غير مكترثٍ بمأساوية نهاية حكم الزعيم، وحجم البؤس والدّمار الذي خلفه. قبل إعلانه عن “الإجراءات الاستثنائية” بأيام، دعا إلى التفكير في تصوّر جديد ضمن “حوار وطني يشارك فيه الشباب التونسي”، وطالب بوضع “بناء قاعدي” يقوم الشعب من خلاله بانتخاب ممثليه. مرّة أخرى، ينهج سعيّد أسلوب القذافي الذي اتخذ “الحوار الوطني” مدخلا لإرساء جماهيريته وإقصاء معارضيه، فقد أقام الأخير سنة 1970 “ندوة الفكر الثوري”، دامت أسابيع وشارك فيها صفوة المثقفين والسياسيين والإعلاميين ومواطنون عاديون. وبينما كان المشاركون يناقشون بجرأة مشروع الثورة الشعبية، كان القذافي يسجّل أسماء من تجرأوا على مطالبة مجلس قيادة الثورة بالعودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين، كي يشقوا طريق الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع. انتهى “الحوار الوطني” بتصفية المعارضين وتكميم أفواه المواطنين. وبينما شَغَل الشعب بمتاهة اللجان والمؤتمرات الشعبية، استأثر الزعيم الليبي بجميع مقاليد الحكم لنفسه، وتبيّن أن الحكمة من إقصائه التمثيل النيابي هي التخلص من المعارضة، وإرساء نظام شمولي ما كان ليستمر 42 سنة لولا ثروات نفطية أهدرها على حماقاته.
سيناريو مشابه قد ينتظر الشعب التونسي إن قَبِلت القوى السياسية والمدنية الانخراط في خدعة “الحوار الوطني” الذي يدعو له الرئيس، لجرّها إلى اصطدام فكري مع قاعدته الشبابية المشحونة بوهم الديمقراطية المباشرة. إذ يستند سعيّد إلى فئات شبابية واسعة تجمع بين اليسار والإسلاميين، وتجمّعات طلابية متشبعة بأفكاره وأفكار شريكه رضا المكي، الملقب رضا لينين، أهم المنظّرين لمشروع الديمقراطية المجالسية الشعبية. ويزعم سعيّد أنه طرح مشروعه سنة 2011، عندما أعرب عن نيته للترشح، وطرحه أيضا سنة 2013 تحت عنوان “من أجل تأسيس جديد”، ثم أعاد طرحه خلال الانتخابات الرئاسية، ما يفيد بأنه مصرّ على المضي في تحقيقه حتى النهاية.
يتمدّد الرئيس يوما بعد يوم في الساحة السياسية، تحت تصفيقات الجماهير وسكون الأغلبية الصامتة. قرابة ثلاثة ملايين ناخب صوّتوا له، لصورة الأستاذ النزيه، الزاهد في السلطة، صاحب اليد النظيفة؛ منحوا ثقتهم للرجل، لا لمشروع ثورته المضادّة. الآن وقد اتضحت خريطة طريقه نحو إسقاط نظام الحكم وتأسيس نظام بديل، أصبح هذا السؤال ملحّا: ماذا يريد الشعب؟ هل سترضى الجماهير التي صنعت من سعيّد رئيسا، أن يحوّل الجمهورية التونسية إلى جماهيرية؟ هل الشعب الذي أسقط نظام زين العابدين بن علي سيعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد؟
يتوقف الجواب على مدى إدراك الشعب بأن مشروعا كهذا جدّ مكلف ماديا، ويعيد إنتاج الصراعات السياسية التي شهدتها تونس على المستوى المركزي، ولكن على نطاق أوسع بكثير. فتعدّد مراكز صناعة القرار قد يشكل، في حد ذاته، عائقا أمام اتِّخاذ القرار، وقد يتحوّل الاختلاف بين هذه المراكز إلى صراعاتٍ واسعة ومتواصلة حول السلطة. وبدل أن يتلاسن ويتعارك 217 نائبا برلمانيا في المكان والزمان نفسيهما، ستتوسع دائرة الصراع حول المناصب والمصالح لتشمل آلاف ممثلي الشعب من مجالس المعتمدية إلى قبّة مجلس البرلمان، مرورا بالمجالس الجهوية، اللهم إن افترضنا مع سعيّد أن كل مواطن يتمتع بوعي سقراط، ومواطنة مانديلا، وعدل عمر بن الخطاب.
التحوّل الديمقراطي الذي يتحدّث عنه الجميع ليس مجرّد آليات انتخابية وتداول على السلطة، بل يحتاج لثقافة الحوار والتفاوض والتنازل، وإدارة عقلانية للخلافات من أجل الوصول إلى توافقات. ومن أهم ما أبرزه الربيع العربي أن الديمقراطية لا تستقيم من دون ديمقراطيين، وأن عيوب النّخب من عيوب الشعوب، والعكس صحيح، فالديمقراطية بالأساس مجموعة قيم وسلوكيات يصعب أن تتوفر في الفضاء السياسي، إن لم توجد في المجتمع بنسبة عالية، وتحكم العلاقة بين الأفراد في البيت والشارع والجامعة والمتجر والمصنع.
طموح المجتمعات العربية إلى الديمقراطية يستوجب إصلاحات ثقافية عميقة. ينبغي التعرّف إلى مكامن الخلل والقصور في الموروث الثقافي والمعرفي والديني، انطلاقا من موقفٍ بناء، بعيد عن كل تبجيل أو إقصاء. فكما يقول محمد عابد الجابريّ: “التّراث هو كلّ ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي، ماضينا نحن أم ماضي غيرنا، القريب منه أم البعيد”.
بين رواسب الماضي وٍآفاق المستقبل تعيش الشعوب العربية حالة تجاذبٍ بين الديمقراطية والاستبداد، لكن ما يبعث على الأمل أنها قد تحرّرت من الركود، وبدأت رحلة الألف ميل بأكثر من خطوة.
العربي الجديد
————————–
مأزق النهضة وثلاثة دروس من تجربة الإسلام السياسي في الحكم/ عريب الرنتاوي
ثلاثة دروس أمكن استخلاصها من تجربة “الإسلام السياسي” في العشرين سنة الفائتة، قبل ثورات الربيع العربي، وبالأخص بعدها: الأول؛ أن أحزاب وجماعات الإسلام السياسي على تفاوتها واختلافاتها، لا تتحول نحو خطاب مدني ديمقراطي من تلقاء ذاتها، بل كنتيجة لتفاعلها و”اشتباكها الإيجابي”، مع قوى مدنية وحداثية أخرى. الثاني؛ أن شرط هذا التحول إنما يتمثل في وجود “معادل موضوعي”، يفوق (أو يعادل) في حجمه ونفوذه وتأثير ما لهذه الحركات من حجم ونفوذ وتأثير. والثالث؛ أن طريق “الإسلام السياسي” للديمقراطية، ليس ذو اتجاه واحد، فثمة منعطفات، ومحطات استدارة للخلف عديدة، مبثوثة على طريقها، من شأنها أن تبقي الباب مفتوحاً أمام “عودة” هذه التنظيمات، إلى “الأصوليات” المؤسسة لخطابها السياسي.
قبل الربيع العربي، وعندما كان العالم العربي غارقا في مستنقع الركود والاستنقاع، في ظلال نُظم سلالية وعسكرية، نُظم الثالوث غير المقدس: “التمديد والتجديد والتوريث”، كان السؤال حول فرص التحاق هذه الرقعة من العالم بأحدث موجات الديمقراطية التي اجتاحت العالم تباعا، يطغى على غيره من الأسئلة والتساؤلات. لكن الإجابة على هذا التساؤل كانت (وما زالت) تصطدم بواحدة من حقائق المشهد العربي الصلبة: “لا ديمقراطية من دون الإسلاميين، ولا ديمقراطية كذلك من دون تبني حركاتهم وجماعاتهم، لخطاب مدني – ديمقراطي”، بيد أن المشكلة الأساس في العشرية التي سبقت عشرية الربيع العربي، تمثلت في أن الديمقراطية في العالم العربي، كانت تصطدم بجدار مسدود، وأن الأنظمة الحاكمة والمتحكمة بدول المنطقة ومجتمعاتها، أغلقت سبل الانتقال للديمقراطية والمشاركة، وأضعفت القوى السياسية والمدنية إلى أقصى الحدود، وأحكمت إغلاق باب المشاركة السياسية، ونفت التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية، وقلصت إلى أدنى الحدود، الفضاء العام لحرية الرأي والتعبير والتنظيم.
يومها كانت الخلاصة، أنه من دون فتح الأنظمة السياسية القائمة لمزيد من المشاركة واحترام التعدد والتنوع وقبول الآخر، سيصعب تشجيع قوى الإسلام السياسي على تبني هذه القيم والمبادئ، ومنعها من الاندفاع نحو خيارات أكثر تشددا وأكثر تشبثا بنزعاتها “الماضوية”، بل وقد يغري شرائح وفئات منها، لبلوغ ضفاف التطرف والإرهاب، كما حصل في تجارب عدة.
بعد الربيع العربي، وفي البلدان التي ضربتها رياح الانتفاضات والثورات خاصة، توفرت الفرصة للإسلام السياسي لاختبار وعوده ومراجعاته التي كان أجراها في العقد الأول من الألفية الثالثة، والتي خرجت بنتيجتها، “دفعة” من الوثائق الإصلاحية، التي كانت بمثابة أولى المحاولات الجادة والجدية، للاقتراب من خطاب الحداثة المدني، إذ استعارت قوى إسلامية عدة، جمل ومفردات من متن خطاب القوى المدنية والديمقراطية، وسعت في إدماجها بخطابها السياسي التقليدي المعروف.
بيد أن هذه الفرصة، التي صمدت “نسبيا” في بعض التجارب العربية: المغرب وتونس، وتعززت بصعود حزب العدالة والتنمية في تركيا (بالأخص في عشرية حكمه الأولى)، لم تتعمم على مختلف التجارب العربية، أو تعممت بأقدار متفاوتة من العمق والتجذر و”التنظير” أو “التأصيل”، حتى جاءت النكسة الكبرى للإسلام السياسي في يونيو 2013 في مصر، وخروج الإسلاميين من أول تجربة للحكم لهم على نحو دام ومروع، لتعود السجالات إلى مربعها الأول.
“الاستثناء التونسي”
لم تكن تونس “الاستثناء” في ثورات الربيع العربي المغدورة فحسب، بل لقد كان إسلامها السياسي كذلك، استثناء من بين تجارب الإسلاميين العرب، سواء في السلطة أو في المعارضة، ولذلك الاستثناء الذي جسدته “النهضة” أسبابه العديدة التي لا مجال للخوض فيها تفصيلا، بيد أن واحدا من أهمها يعود لسنوات المنفى الأوروبي-الفرنسي الطويلة لقادة النهضة، في الوقت الذي آثر فيه نظراؤهم المشرقيون اللجوء إلى دول خليجية (وهابية في أصلها)، كملاذ من بطش الأنظمة والحكام، سيما وأن أجندات الطرفين تلاقت زمن الحرب الباردة، في مواجهة المد الشيوعي والقومي في المنطقة آنذاك.
لكن بالعودة إلى الدروس الثلاثة التي بدأنا بها هذه المقالة، وإعادة قراءتها في ضوء “الاستثناء التونسي”، يمكن تسجيل الملاحظات الجوهرية التالية:
الأولى؛ أن تونس منذ “البورقيبية”، بخلاف مصر ما بعد يوليو 1952، مرت بمخاض طويل لتجذير العلمانية، وتمتعت بوجود مجتمع مدني وقوى سياسية ومدنية فاعلة ونافذة، دخلت في سجالات فكرية وسياسية وحقوقية مع النهضة، قبل الثورة، في المنافي والشتات، وبعدها، في ظل سيادة مرجعيات غربية لهذا الحوار، لم تستطع “النهضة” تجاوزها أو التنكر لها. السجالات المبكرة، داخل النهضة من جهة، وبين النهضة و”مجادليها” من جهة ثانية، أمكن لها حفز العقل السياسي والفكري لإسلاميي تونس، وتمكينهم من تصدر صفوف التيار الإسلامي المدني في العالم العربي. مثل هذا التطور ساعد على تشكل تجربة “الاستثناء التونسي”، إذ من دون ملاحظة الفوارق بين النهضة ونظيراتها في المشرق والجزائر ومصر، يصعب فهم هذا الاستثناء، ولعل من الإنصاف القول إن النهضة وإخوان مصر أو الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، ليسوا من قماشة واحدة. ودعونا نعترف أن تجربة الإسلام السياسي التونسي، لم تهبط بردا وسلاما على كثيرين من نظرائهم في المشرق الذين قابلوها بكثير من الشك المعلن وقليل الاتهام الصامت، وأنها كانت تحظى بترحيب وارتياح قوى إصلاحية مدنية وعلمانية فيه، أكثر مما كانت تلقى لدى إسلامييه في كثير من الأحيان.
والثانية؛ أن المجتمع المدني التونسي بمنظماته الوطنية الكبرى، إضافة لوجود أحزاب علمانية متنوعة، سيشكل “المعادل الموضوعي للإسلام السياسي التونسي، بخلاف مصر وتركيا، حيث “الدولة العميقة” و”المؤسسة العسكرية” لعبتا هذا الدور، ما أدخل البلاد في “ثنائية العسكر والإخوان” تاريخيا. وحين يتوفر “معادل موضوعي”، مدني وديمقراطي، يصبح من الممكن الرهان على انتقال سلس وسلمي وتوافقي نحو ضفاف الديمقراطية. هذا الشرط، لم يتوفر إلا لتونس، وهو أسهم (من بين عوامل أخرى) في صياغة “استثنائها”.
الثالثة؛ وتشترك فيها تجربة الإسلام السياسي في تونس مع غيرها من تجارب الإسلاميين في الحكم، إذ حين تستقر هذه الحركات في السلطة أو على مقاعد الأغلبية، وإذ تركن إلى فوزها المتكرر في الانتخابات والاستفتاءات، فإن الباب يفتح أمامها، لاستحداث الاستدارة، أو ربما النكوص عن وعود والتزامات ومراجعات سابقة (أنظروا ما الذي حصل لإردوغان وحزبه الحاكم في عشرية حكمه الثانية). النهضة في هذا المجال، لم تكن استثناء عن بقية حركات الإسلام السياسي، ولم تنج بدورها من مفاعيل نظرية “التمكين” ومندرجاتها، كما تجلت في غير مكان، ولم يكن مستبعدا أبدا، لو بقي الحال على حاله، أن تستحدث النهضة “استدارة ما بعد التمكين”، كما حصل في غير موقع وتجربة.
ومن دون تبرئة بقية القوى السياسية والمدنية من خطاياها التي ليست موضوع مقالتنا لهذا الأسبوع، يمكننا القول إن النهضة استمرأت السلطة و”الأغلبية”، ومارست شتى أنواع الاستعلاء على القوى الأخرى، بل وحتى على شعبها الذي منحها ثقة أغلبيته، وتورطت في ألاعيب السلطة وتحالفاتها وفسادها، ولم تتورع عن الاستقواء بالخارج لدعم صناديقها وتعزيز حضورها السياسي والإعلامي، وغلبت مصلحة “الجماعة” والمحور الإقليمي الذي تنتمي إليه، على مصالح الدول والمجتمع في تحالفاتها الخارجية، وهذا باعتراف قادتها، من انشق منهم ومن بقي في موقعه، وما المراجعات والانشقاقات والسجالات المحتدمة التي تجري في أوساطها اليوم، سوى إرهاصات على صحوة متأخرة، أملتها الحقائق الصادمة لأزمة الأسبوعين الأخيرين في تونس.
ولنا أن نتخيل السيناريو التالي لتوضيح ما نود قوله: لو أن الشعب التونسي استجاب لنداءات راشد الغنوشي أثناء اعتصامه أمام البرلمان، وخرج إلى الشوارع بمئات الألوف أو بمليونيات كما يقال، في استعادة لسيناريو تركيا 2016، هل كانت النهضة ستشهد كل هذه السجالات، وتجري كل هذه المراجعات؟. هل كان الغنوشي سينقلب على نفسه، فيتحول من وصف إجراءات الرئيس سعيد من “انقلاب موصوف ومكتمل الأركان”، ينذر بعودة “الاستبداد”، إلى “فرصة للإصلاح” وتصويب المسار، واستعداد لتقديم كل تنازل مطلوب للخروج من عنق الزجاجة، بل وإبداء “التفهم” لما قام به الرئيس التونسي بوصفه مرحلة من مراحل الانتقال التونسي؟، ما الذي كانت النهضة لتفعله لو قُدّر لها أن تطيح بالرئيس سعيّد بأي وسيلة؟، هل كنا سندخل مرحلة “تصفية الحساب” مع الخصوم والمجادلين على غرار “اجتثاث البعث” في العراق، أو بتصفية مؤسسات الدولة وأحزابها وقواها تحت شعار “اجتثاث البورقيبية”، كما فعل إردوغان بعد محاولة انقلاب 2016 تحت شعار “تصفية الدولة الموازية”؟
لقد فاجأت التحولات في مواقف النهضة من إجراءات الرئيس سعيّد وتدابيره الاستثنائية، الرأي العام، وأخذت نظراءهم العرب على حين غرة، فقد سبق لجماعات إخوانية وإسلامية عدة، أن ذهبت إلى أقصى حد، في الهجوم على “الانقلاب”، وسارعت إلى استذكار تجربتي مصر 2013 وتركيا 2016، واستحضار “خطاب المظلومية” كما لم تفعل النهضة ذاتها، بل أن بعضها ذهب حد الاستنتاج بأن حركات الإسلام السياسي مستهدفة، أيا كانت التحولات التي يمكن أن تكون قد استحدثتها على خطابها وبرامجها وأدائها. والحق، أن مواقف النهضة، المُستهدفة بإجراءات الرئيس التونسي كما يقال، جاءت أكثر واقعية وعقلانية، من مواقف كثير من حركات الإسلام السياسي العربية والمشرقية، التي برهنت بردود أفعالها تلك، أنها “كاثوليكية أكثر من البابا نفسه”.
في مقالتنا الأسبوع الفائت على موقع الحرة: “الاستثناء التونسي…كلاكيت 2″، استبعدنا أن تقتفي تونس أثر السيناريو الجزائري وعشريته السوداء، أو سيناريو مصر 2013 وتركيا 2016، وعرضنا لفوارق التجارب الأربع. بعد أسبوعين على الحدث التونسي، تعاود تونس تجربة الاستثناء، تدخل النهضة في مأزق المراجعات والسجالات الداخلية، ويعاود المجتمع المدني دوره الريادي في تأمين شبكة أمان للانتقال، وفي ظني أن تونس ستحافظ على “استثنائها”، أما النهضة فمن المرجح أن تنتهي إلى طبعة جديدة، مزيدة ومنقحة، سيما إن قُدّر لجيل الشباب فيها، أن يواصل ضغطه لتجديد الحركة وتشبيبها، ودفعها للانخراط في شراكة (لا مغالبة) مع بقية القوى السياسية والمدنية التونسية، والتخلي عن النزعات الثأرية والانتقامية من العهد البورقيبي، التي ميزت خطاب شيوخ الحركة، وتفكيك عرى تحالفاتها الضارة مع قوى وعواصم تدخلية، لا تخفي أحلامها الإمبراطورية في الإقليم برمته، وللحديث صلة.
الحرة
————————
الإسلام السياسي مِن نجاح التعبئة الجماهيرية إلى فشل الحكم/ إياد العنبر
انشغلت دراسات العلوم الاجتماعية في نهايات القرن الماضي بظاهرة صعود حركات الإسلام السياسي، واتفق أغلب الباحثين على تفسير ذلك الصعود كنتيجة لعوامل عدّة، أهمها: أزمة الهوية والشعارات التي رفعها الإسلاميون بإحياء الهوية الإسلامية في مواجهة مشاريع التحديث والتغريب، ومن بينها هوية الدولة ونمط إدارتها، وإخفاقات سياسات ومشاريع التنمية التي وعدت بها أنظمة الحكم والتي لم تنتج إلا زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وساهمت بترسيخ الانقسام الاجتماعي. وأيضاً اعتماد الدكتاتورية كنمط للحكم في المجتمعات الإسلامية.
لذلك كان ظهور الاتجاهات السياسية الإسلاموية هو تعبير لردّ فعل سياسي واجتماعي وثقافي يبحث عن شكل سياسي-اجتماعي جديد وفعّال يريد إحياء الهوية الدينية باعتبارها أصيلة وغير مستورَدة وترفع شعارات إسلاميّة ذات بريق وجاذبية، وتعتبرها حلولاً لم تُطبَّق في الأزمة الحاضرة. ومن هنا حاول الإسلام السياسي تقديم نفسه كبديل للأيدولوجيات العلمانية التي تبنتها الأحزاب والأنظمة الحاكمة.
يفسّر “جيل كيبيل” الباحث الفرنسي المتخصص بالحركات الإسلامية السياسية، قدرةَ هذه الحركات على التحشيد الجماهيري، إذ يرى أنّها تعتمد إمكانيتها في التغلغل الاجتماعي داخل طبقات محددة وبشعارات لها القدرة على الاستقطاب، معتقداً بأن النجاح السياسي لحركة إسلاميةٍ أو إخفاقها في بلد ما، رهين بمدى قدرة هذا التنظيم على التعبئة الاجتماعية؛ ويرى أن هذه التعبئة تكون ناجحة إذا ما استطاعت أن تضم ثلاث فئات مختلفة هي: الشباب الحضري الفقير، والنخب المثقفة المعارضة للأنظمة، وأخيراً البرجوازية الورعة. وكلّ فئة تتداخل مع الأخرتَين وتتفاعل. ولكلّ وحدة منها مرجعيتها الاجتماعية، وبرنامجها السياسي، ومواردها السياسية الخاصة بها، وهي لا تستطيع أن تكون فاعلة إلا إذا تظافرت مع الأخرتَين.
لذلك لم يكن مستغرباً مِن هيمنة قوى الإسلام السياسي على المجال العام في الدول التي شهدت سقوط الدكتاتورية والتحول نحو تبني الديمقراطية، ففي العراق وفي بلدان الربيع العربي كان وصول حركات الإسلام السياسي إلى سدّة الحكم هو أسهل الطرق في ظلّ التحوّل الديمقراطي، لأنَّهم الأكثر فاعلية وتنظيماً في تحشيد الأتباع في مواسم الانتخابات، لكنّهم عجزوا عن تحقيق تغيير على المستوى السياسي والاقتصادي الذي يمنحهم شرعية المنجَز، والتي توثق علاقتهم بالجمهور.
قوى الإسلام السياسي لا تتحمل خطيئة الفشل لوحدها، وإنما البيئة السياسية التي نشأت وعملت فيها في أيام المعارضة لم تساهم في إنضاج تجربتها السياسية، إذ أن هناك علاقة سببية وثيقة ما بين طبيعة وبنية النظام السياسي القائم ودور قوى المعارضة السياسية وسلوكها، ومن ثمَّ تكون المعارضة امتداداً طبيعياً للثقافة والسلوك السياسي السائد في بلد معين.
ولذلك فالمعارضة هي الوجه الآخر للنظم السياسية القائمة، حيث تتعلّم أساليبها وتتبنى أطرها وآلياتها وسلوكها العام إذا وصلت للحكم!
والمأزق الذي وقعت فيه حركات المعارضة الإسلامية يكمن في أنها بدأت تخسر مشروعَها السياسي الذي تسعى فيه إلى أسلمة الدولة والحكم، وبدأت تدخل في مساومات وتنازلات من أجل البقاء في السلطة. وخسرت فاعليتها الاجتماعية القائمة على أساس معارضتها للدكتاتورية ومطالبتها بحقوق الطبقات المسحوقة، بعد أن أمست ممارساتها في إدارة الدولة تتجه نحو الاستئثار بالسلطة والهيمنة عليها. وكما يقول كنعان مكيّة في كتابه جمهورية الخوف: (إن ضحايا القسوة والظلم ليسوا أفضل من معذبيهم، بل أن وضعهم في العادة ليس أكثر من مجرد انتظار لتبادل الأدوار معهم.)
حتّى عنوان ورمزية المقاومة التي كانت ترفعها الحركات الإسلامية، باتت تواجه سؤالاً إشكالياً، بأنها مشروع تحرير الأرض؟ أم مشروع للوصول إلى السلطة، والمشاركة في مغانمها؟ ناهيك عن تخلّيها عن شعارها الوطني في تحرير البلاد والعباد من هيمنة دول الاستكبار، إذ باتت رهينة لإرادات إقليمية تعتقد بأن أمنها القومي يرتبط بالنفوذ السياسي والعسكري في الدولة الهشّة.
تجربة الإسلام السياسي في الحكم كانت كاشفة لمنهج الحركات الإسلامية المعاصرة في سعيها للحكم ونزعتها للتفرد به من دون مشروع سياسي قادر على تقديم أنموذج يختلف عن حكم الأنظمة التي كانت تعارضها. كما أثبتت بأن توظيف الإسلام السياسي للدين يتجه للجماهير لتعبئتها وحصد ثمار أصواتها، لا لملاقاة حاجاتها المجتمعية، ويغفل حلمها بالعدل ويمنحها ويغرقها بدلاً من ذلك بإسلام طقوسي، وبشعارات لا يوجَد لها مصداق على أرض الواقع.
نجاحات الإسلام السياسي في استقطاب الجمهور ومن انتماءات طبقية متنوعة، لم تستمر في ممارسة الحكم! لأنَّ الايدولوجيات التي ترفعها الحركات السياسية هي معيار للحكم على مصداقيتها في قدرتها على أن تكون واقعاً وليس شعارات. وإدارة وحكم المجتمع السياسي محكومة بتوازنات سياسية على أرض الواقع، إذ أثبتت التجربة بأنَّ الإسلاميين غير قادرين على إدارتها لأنَّهم يؤمنون بأنهم يملكون تفويضاً نضالياً ومهمة رسالية تتعالى على مصدر الشرعية التي يمحنها المجتمع. لذلك حين تخسر قوى الإسلام السياسي المبادرة والقدرة على فرض الواقع الذي تريده، فإنّها تخسر أيضاً مبررات وجودها ومشروعيتها.
كلّ الأدبيات التي منحت الحركات السياسية الإسلامية قوّةً استثنائية في تحشيد الجماهير في معارضة الأنظمة الدكتاتورية، والتي تحوَّلت إلى شعارات وخطابات سياسية تسعى لتعبئة الأتباع نحو المشاركة السياسية للوصول إلى الحكم، هي ذاتها نقطة ضعفها الكبرى. فمثل هذا الشعارات قادرة على أن توعد الجماهير بالفردوس وتحقيق العدالة التي يحلم بها المهمَّشون والطبقات المسحوقة، لكن التجربة أثبتت عجز الإسلامويين عن تحويلها إلى واقع قائم ومستمر على الأرض.
———————————-
“عتاب” استثنائي للغنوشي ورغبة سريعة في تغيير القيادة.. الأزمة السياسية في تونس تتسبب في انقسام “النهضة”
عربي بوست
تعيش حركة النهضة التونسية انقساماً داخلياً أصبحت تتضح ملامحه بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو/تموز 2021، رغم محاولات قياديين طمس الاختلافات، ومحاولة حلها في “البيت الداخلي”.
وشهدت الدورة 52 من مجلس شورى حركة النهضة (هيئة القياديين)، يوم الخميس الماضي 5 أغسطس/آب 2021 خلافات حادة لم تعرف الحركة مثيلاً لها خلال العشر سنوات الأخيرة بعد الثورة، من بينها ضرورة إجراء المؤتمر 11 لتغيير القيادة الحالية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست” فإن مجلس الشورى الذي عُقد يوم الأربعاء، وامتد لصباح يوم الخميس كان من المفروض أن ينعقد السبت الماضي، لكنه تم تأجيله بسبب خلافات حادة بين عدد من قياداته، التي طالب بعضها بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة الحركة، وتقديم نقد لسياسات الحركة.
وحمّل عدد من أعضاء مجلس الشورى القيادة الحالية للحركة مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها تونس، منها التحالفات السياسية مع الأحزاب الأخرى التي لم تكن موفقة، وصد باب الحوار مع رئيس البلاد قيس سعيّد.
انقسام داخل حركة النهضة
ساهم الزلزال السياسي في قصر قرطاج مساء 25 يوليو/تموز 2021 في زلزال داخلي وسط حركة النهضة، باعتبارها الكتلة الأكثر تمثيلاً في البرلمان الذي تترأسه، والمعنية بشكل كبير بالقرارات التي اتخذها سعيّد.
وكشف محمد القوماني، النائب البرلماني عن حركة النهضة، أن “موقع راشد الغنوشي، رئيس الحركة، لم يكن موضوع خلاف داخل مجلس الشورى، والخلافات التي ظهرت بين القيادات تعود جذورها إلى خلافات سابقة لها علاقة بالمؤتمر 11 للحركة، الذي من المنتظر أن يُعقد في نهاية العام الحالي”.
وترتكز الخلافات بين قيادة النهضة، حسب المعلومات المتوافرة لـ”عربي بوست” حول قيادة الحركة، إذ إن الأعضاء يُطالبون بعقد المؤتمر 11 في موعده المقبل دون تأجيل جديد، وذلك لتغيير القيادة الحالية.
وعن كواليس مجلس الشورى، يقول النائب البرلماني القوماني إن أعضاء المجلس اقترحوا حلّ المكتب التنفيذي للحركة وتعويضه بـ”خلية أزمة” محدودة العدد، وعُرض المقترح للتصويت، قبل أن ينسحب عدد من القيادات من الاجتماع، وهم في الأصل من قدموا المقترح، فكانت النتيجة التصويت بالرفض لقلة الأصوات”.
وتنقسم محاور الخلاف داخل حركة النهضة إلى داخلية وعامة متعلقة بإدارة الشأن العام وشؤون الحُكم. ففي الجانب الأول، تُلام القيادة الحالية على عدم احترام مؤسسات الحزب، وأن قرارات كثيرة وقع اتخاذها من طرف رئيس الحزب ومقربين منه دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
أيضاً، يعتقد ما يُعرف بـ”التيار الإصلاحي” داخل “النهضة” أن بقية هياكل الحركة وكذلك عدد من رموزها التاريخية لا تقع استشارتهم أو الرجوع لهم في عدد من المسائل المصيرية، وبالتالي يُطالبون بحل المكتب التنفيذي، وفقدانه الصفة بما في ذلك راشد الغنوشي، أو تفويض هذا الأخير لمن يقوم مهامه احتراماً إلى رمزيته وقيمته في تاريخ حركة النهضة.
الجانب الثاني يتعلق بإدارة حركة النهضة للشأن العام واختيار الأولويات والتحالفات، مستجيبةً لقيم الثورة، إذ يُعتقد أن التحالفات التي كانت مع حكومة الفخفاخ مقبولة، وخاصة ما كان مع التيار الديمقراطي، على عكس الآن.
ويرى المعارضون للرئيس أن الغنوشي غلّب البُعد الحزبي على البُعد الوطني في محطات كثيرة هامة، من التوافق مع حزب نداء تونس، بعد انتخابات 2014، الأمر الذي كان تكتيكياً ونتائجه عادت بالسلب على البلاد، حتى أنه لم يُمكن تأسيس المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية.
واعتبر المعارضون لسياسة الغنوشي أن التوافق مع “نداء تونس”، كان بين زعيمين سياسيين وهما راشد الغنوشي، والراحل القايد الباجي السبسي، لكن هذا التوافق لم يكن نهائياً بين المؤسستين الحزبيتين.
ويجد المعارضون أن الغنوشي وحده وليس الحزب من له علاقات مع كل الأطراف بما في ذلك المنظمات الوطنية والاجتماعية الكبرى التي يتواصل معها، كأن يعقد لقاءات مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكن في الأصل ليس ثمة تواصل حقيقي بين مؤسسات حركة النهضة وهياكل الاتحاد.
من جهة أخرى، عبّر التيار الإصلاحي داخل “النهضة” عن ضرورة أن تقدّم قيادة جديدة النقد الذاتي لا أن تقدمها القيادة الحالية، كما جاء في البيان الختامي لـ”شورى النهضة”، وأن هذا النقد ضروري ويجب أن يشمل التصورات للمجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
واعتبر التيار الإصلاحي داخل “النهضة” أن قيادة الحركة انتهجت مبدأ “الصراع” مع الرئيس قيس سعيّد منذ انتخابه، عوض البحث عن قنوات حوار دائمة، والتي تحتاجها تونس في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى.
ماذا بعد أزمة “النهضة”؟
قال النائب البرلماني الذي حضر اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة إن الخلاف الحاد الذي أفضى إلى انسحاب بعض قيادات الحركة من الدورة في ظرفية حساسة وطنياً وحزبياً سيكون له ما بعده.
وأضاف المتحدث أن “هناك خلافاً حقيقياً في تشخيص الأوضاع وفي اقتراح الحلول المناسبة، فضلاً على الخلاف الحاصل أصبح واضح حول المؤتمر 11 ورهان الانتقال القيادي من الغنوشي إلى شخص آخر”.
وبسؤالنا عن إمكانية تعديل الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة، الذي لا يسمح لراشد الغنوشي بمواصلة الرئاسة بعد المؤتمر القادم (المؤتمر 11)، أكد القوماني أن الأمر محسوم ولن يتم التعديل، ما يعني أن زعيم الحركة سيغادر القيادة في كل الأحوال.
ويمنع الفصل 31 من القانون الداخلي للحركة نفس الشخص من الترشح للمرة الثالثة، وصدرت في 15 سبتمبر/أيلول 2020 عريضة تطالب بعدم تعديل الفصل وقعها 100 من الأعضاء بينهم قيادات، كما صدرت عريضة ثانية قبل أسابيع وقعها 130 عضواً.
إعادة النظر في التحالفات
عبر أعضاءُ مجلس نواب الشعب والذين هم في ذات الوقت أعضاء مجلس الشورى، وأبرزهم سمير ديلو، ويامينة الزغلامي، وجميلة الكسيكسي، عن مواقف منتقدة للقيادة الحالية، على رأسها راشد الغنوشي.
وتحالفت “النهضة”، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، مع حزبي قلب تونس الذي يُلاحق رئيسُه نبيل القروي في قضايا فساد وتبييض أموال، ومع ائتلاف الكرامة الذي يثير ناطقه الرسمي سيف الدين مخلوف جدلاً دائماً في خطابه وسلوكه السياسي الذي يصفه المُتابعون بـ”الشعبوي”.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست” فإن مجلس شورى حركة النهضة تم تداول فيه مسألة التحالفات ما قبل سنة 2019 وما بعدها، وعلاقتها بتعثر المسار الديمقراطي.
وقال النائب البرلماني التونسي القوماني إن حركة النهضة بالتأكيد ستعيد دراسة تحالفات ما بعد 25 يوليو/تموز، والتي بالتأكيد ستكون مختلفة عما قبلها (في إشارة إلى إمكانية فك الارتباط بالحليفين الحاليين).
وأضاف المتحدث أن خارطة الأغلبية البرلمانية الممكنة في حال عاد مجلس نواب الشعب إلى نشاطه، فشروط التحالف مع الكتلة الديمقراطية (الثانية في البرلمان) تبدو معقدة بحكم تباين المواقف من حدث 25 يوليو 2021، والخلافات بين الطرفين منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.
وأشار المتحدث إلى أن “تخلي النهضة عن حليفيها سيجعلها دون سند سياسي قوي، كما أنه يُستبعد أن تتوصل النهضة إلى تحالفات مع الكتل البرلمانية الصغيرة، التي لا تبدو مواقفها الحالية من قرارات سعيد ثابتة إلى حد الآن”.
وقال محمد القوماني إن “الخلاف في دورة الشورى حول تشخيص الأزمة وحلولها ومعالجتها سياسياً وتنظيمياً سيُلقي بظلاله على مستويات أخرى في الحركة ومن بينها كتلة النهضة في البرلمان”.
واعتبر المتحدث أن “المنعرجات السياسية والأجواء المشحونة تؤدي أحياناً إلى قرارات مستعجلة، قد يتم التراجع عنها لاحقاً، ولكن الخلاف صار واضحاً في صفوف القيادات”.
“النهضة” وسعيّد
عبر مجلس الشورى بوضوح عن مد اليد إلى رئيس الجمهورية لحوار سياسي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية “التي لن تحل المشكلة”، حسب تصريح القوماني.
وعبر الشورى عن الاستعداد للتعاطي الإيجابي مع ما يمكن أن يُساعد على الخروج من الأزمة وعودة البرلمان إلى مهامه “مع تحسين أدائه وإعادة ترتيب أولوياته”.
وجمع الشورى في موقفه بين التمسك بالموقف الرافض لـ”الانقلاب” ومرونة في التعاطي مع المرحلة الجديدة.
وبيّن عضو الشورى محمد القوماني أن هذا الموقف من شأنه أن “يُجنب أنصار النهضة المواجهة مع الدولة والانجرار إلى العنف.. والمراهنة عوض ذلك على الحوار والحلول السياسية”.
وقال القوماني إن “المجلس قد ثبت الموقف المبدئي للحركة من القرارات الرئاسية التي خرقت الدستور والتي مثلت انقلاباً عليه، وخرج ببيان اعتبر فيه قرارات سعيّد انقلاباً على الدستور، يحتاج إلى الحوار”.
وأضاف المتحدث أن “الحزب أخذ بعين الاعتبار تلك القرارات التي لاقت دعماً وتأييداً في أوساط شعبية وسياسية، ووقفت معها مؤسسات الدولة من جيش وأمن وصارت أمراً واقعاً”.
———————————
“حركة النهضة” وواشنطن… مياه كثيرة جرت تحت الجسر / احمد نظيف
خريف عام 1991، وقف راشد الغنوشي، مؤسس وزعيم “حركة النهضة” التونسية، في أحد معسكرات الحركة في مدينة أم درمان السودانية خطيباً غاضباً متوعداً الولايات المتحدة الأميركية بالويل والثبور وعظائم الأمور، وملوّحاً بالهجوم على قواتها في جزيرة العرب، في أعقاب الغزو العراقي للكويت. كانت العقيدة الإخوانية التونسية حينذاك مثقلة بشعارات “مناهضة الاستكبار العالمي” ومعجبة بالسياسات التي اجترحها الإمام الخميني في إيران.
خلال ثلاثة عقود من التحول والتبدل، أصبح الغنوشي يقف في المعسكر المقابل. لم يعد الرجل مهتماً بــ”الجهاد ضد الاستكبار الأميركي” بقدر ما أصبح يتوسل قوة هذا “المستكبر” كي ينقذه من مآزقه العديدة. بين لحظة أم درمان العاصفة، واللحظة التي نعيش، جرت مياه كثيرة تحت جسور المنطقة وتحت جسر الحركة الإسلامية التونسية، تلخّص في رمزيتها مسيرة الغنوشي وتحولاته العجيبة.
مناسبة هذا القول ما كشف عنه موقع وزارة العدل الأميركية من أن “حركة النهضة” قد وقعت عقداً جديداً مع إحدى شركات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن، في أعقاب الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) الماضي، من أجل القيام بحملة علاقات عامة لفائدة الغنوشي وحركته، أي “نصرتها” ضد الرئيس سعيد، وقد بدا ذلك جلياً أياماً قليلةً بعد تجميد عمل المجلس النيابي وإقالة الحكومة من خلال نشر مقالات لراشد الغنوشي في بعض الصحف الأميركية لمخاطبة الإدارة الأميركية والرأي العام الأميركي، وكأن الغنوشي لم يعد يهمه جمهوره المتخلي عنه في الداخل، بقدر ما يهمه الموقف الأميركي في إعادة ترجيح موازين القوى لفائدته، والعودة للوضع الذي كانت عليه السلطة قبل 25 تموز 2021. بيد أن الحركة نفت أن تكون قد وقعت أي عقد أو قامت بتحويل أموال نحو الولايات المتحدة، لكأنها تعتقد أن المهتمين بتاريخ الجماعات الإسلامية ونشاطها يجهلون الشبكات الخارجية الداعمة للحركة، التي بقيت نحو عقدين تنشط في الخارج ولديها بنية تحتية لوجستية وتنظيمية هائلة في العواصم الأوروبية وفي أميركا الشمالية، تمكّنها من التواصل مع مثل هذا النوع من الشركات وتحويل الأموال من دون أن يمر ذلك على تونس ومن دون أن تكشفه أجهزة الرقابة المحلية التونسية.
لكن التوجه نحو واشنطن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يبدو أنه سيعمق من مشكلات الحركة الإسلاموية التونسية، حيث شرع القضاء التونسي في التحري والتقصي عن مدى صحة وثيقة التعاقد وحقيقتها، والتي يمكن أن تكون دليل إثبات آخر في ملف عقود شركات الضغط المتهمة فيها “حركة النهضة” منذ انتخابات 2019، إذ أعلن القضاء التونسي في وقت سابق عن فتح تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق “حركة النهضة” بتهمة تلقي تمويل خارجي، بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات – أعلى هيئة قضائية رقابية – والذي دان “النهضة” بالتمويل الخارجي من خلال عقود شركات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن. وإذا أثبت القضاء هذه التهم، فإن “النهضة” تواجه مخاطر وجودية عير مسبوقة، ليس أقلها الخروج النهائي من المشهد السياسي لسنوات. إذ يشير الفصل 163 من الدستور التونسي الجديد إلى أنه: “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من أُدين بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية”.
وبالعودة الى العلاقات بين “حركة النهضة” وواشنطن، فإنه يمكن القول إن نوعاً من خيبة الأمل قد أصاب الإسلاميين في تونس، بعد الموقف شبه الحيادي للإدارة الأميركية مما حدث على يد الرئيس قيس سعيد، حيث كانت تقديرات الحركة الإسلاموية تشير إلى أن الموقف الأميركي سيكون أكثر قوة وتشدداً إلى صفهم، لكن ذلك لم يحدث، فيما واصلت السفارة الأميركية تقديم جرعات اللقاح بل زادت من وتيرة المساعدات، على الرغم من الودّ غير الخفي بين الإدارة الديموقراطية والإسلاميين، بخاصة في تونس، الذين فتحوا قنوات اتصال مع السفارة منذ سنوات، قبل حتى عودتهم للنشاط السياسي عام 2011، وقد كشفت وثائق ويكيليكس في العام نفسه عن تفاصيل دقيقة لاجتماعات قيادات الحركة بالدبلوماسيين الأميركيين ومواقفهم.
لم تدّخر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، خصوصاً وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، وقتذاك، جهداً في دعم وصول “حركة النهضة” إلى السلطة، ودعمها خلال سنوات حكمها القليلة. كانت الفلسفة الأميركية، مدفوعة بملخصات مراكز البحوث في واشنطن، تراهن على أن وصول حركات إسلامية “معتدلة” سيقضي نهائياً على الحركات الإسلامية الجهادية، ما دامت هذه الحركات المعتدلة لا تتبنى سياسات جذرية ضد المواقف والسياسات الأميركية في المنطقة، ولا ضد النموذج الاقتصادي الرأسمالي.
كان هاجس الأمن وترويض الوحش السلفي الجهادي مسيطراً على الأميركيين، واعتقدوا أنه بوصول جماعات إسلامية إلى السلطة سيكون من السهل إعادة إدماج الجهاديين والسلفيين في لعبة السياسة وضبط الأمن. لم تصمد هذه الاعتقادات الأميركية طويلاً أمام الواقع. بضع مئات من الشباب السلفي الجهادي هجموا سيراً على الأقدام وفي صناديق الشاحنات على السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في تونس العاصمة يوم 14 أيلول (سبتمبر) 2012، وأسقطوا كل الحسابات في الماء، بينما كانت “حركة النهضة” على رأس الحكومة حينذاك ولم تحرك ساكناً.
النهار العربي
—————————-
===================
تحديث 10 آب 2021
————————-
السخط الشعبي على الديمقراطية… حالة تونس/ عمرو حمزاوي
في 25 يوليو/تموز الماضي، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد المادة80 من الدستور لتمرير تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وانتزاع سلطات المدعي العام الأول في مرفق النيابة العامة. برر سعيد إجراءاته بحالة «الخطر الداهم» التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا تعصف بها وسوء الأداء يضرب المرافق الحكومية والاحتجاجات الشعبية والإضرابات الفئوية تتصاعد. وعلى الرغم من إجراءات الرئيس التونسي تعرض تجربة الانتقال الديمقراطي التي بدأت في 2011 لأزمة جديدة وتهدد بالعودة إلى حكم الرجل القوي، إلا أن ثمة أزمات أعمق تحيط بالمجتمع والدولة والسياسة في تونس وتضع الانتقال الديمقراطي في مواجهة تحديات أخطر بكثير.
أعلن سعيد إجراءاته وأغلق مقر البرلمان وشرع في إقالة الوزراء والسفراء وسط ترحيب صريح من قبل مواطنات ومواطنين لا ينكرون سخطهم على السياسيين والأحزاب والبرلمان المنتخب والمؤسسات الحكومية غير الفاعلة. كانت زيارتي الأخيرة لتونس في 2019 لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جاءت بسعيد إلى قصر قرطاج وبحركة النهضة الإسلامية كالكتلة الأكبر في البرلمان. قضيت بين العاصمة وبين شمال غرب البلاد (جندوبة) ما يقرب من أسبوع لم تتوقف خلاله شكوى جميع من التقيت، وعلى تباين مستوياتهم التعليمية ومجالاتهم المهنية وأحوالهم المالية، من التدهور البالغ للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما لم ينقطع أيضا تعبير الناس عن الغضب من الأحزاب غير المسؤولة والسياسيين الفاسدين اللاهثين وراء الإثراء والكسب غير المشروع. وعلى الرغم من أغلبية الناخبات والناخبين (فوق ال50 بالمائة) شاركت في الاقتراع لاختيار رئيس وبرلمان ودللت بذلك على التزامها بالعملية الديمقراطية، غير أن مناسيب السخط الشعبي على السياسة والسياسيين من كافة الأطياف الإيديولوجية كانت مدعاة للقلق.
ووثقت استطلاعات الرأي العام التي أجرتها في تونس مؤسسة «البارومتر العربي» (تديرها جامعة برينتسون الأمريكية وفرق من المتخصصين في البلدان العربية https://www.arabbarometer.org/) وضعية السخط الشعبي تلك بوضوح. ففي تقرير عن اتجاهات الرأي العام نشر في 2019، سجل أكثر من 93 بالمائة غضبهم الشديد من سوء الأوضاع الاقتصادية وفقدانهم للأمل فيما خص احتمالات التعافي المستقبلي. وسجلت ذات معدلات الغضب الشعبي في 2020، وترافقت مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة لتصل إلى 15 بالمائة و17 بالمائة على التوالي. وثقت استطلاعات البارومتر العربي أيضا شيوع التقييم السلبي لعمل المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة، خاصة البرلمان. اتهم أكثر من 90 بالمائة الحكومة بالفساد إما «إلى حد كبير» أو «إلى حد متوسط» وانهارت ثقة السكان الذين تجاوز تعدداهم 11 مليون في المؤسسات الحكومية من 62 بالمائة في 2011 إلى أقل من 20 بالمائة في 2019. أما البرلمان، فلم يشعر بالثقة تجاهه في 2019 سوى14 بالمائة من السكان في مقابل 31 بالمائة في 2011.
سياسيا، أصاب السخط الشعبي على السياسة والسياسيين حركة النهضة الإسلامية على نحو أشد من الأحزاب والحركات الأخرى. فقد صارت حركة النهضة، وهي تشكل بحوالي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان الكتلة الأكبر ولم ترغب سوى أن تضطلع بدور قيادي في تشكيل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، محاصرة باتهامات سوء إدارة البرلمان وضعف أداء الحكومة وشبهات فساد منتسبيها على المستويين الوطني والمحلي. قبل إجراء سعيد بتجميده، كان البرلمان قد تحول إلى ساحة للاستقطاب والشد والجذب الإيديولوجي وليس للعمل التشريعي والرقابي المسؤول. قبل إجراء سعيد عزلها، كانت الحكومة ومرافق الدولة تتهاوى على وقع الاحتجاجات الشعبية والإضرابات الفئوية التي أججها عصف جائحة كورونا بالبلاد. قبل أن يمكن سعيد برفع الحصانة عن نواب البرلمان السلطات القضائية من الشروع في التحقيق في شبهات فساد بعضهم، كانت منظمات المجتمع المدني تواصل نشر التقارير الموثقة عن فساد في البرلمان والحكومة والسلطات المحلية وتعلن أسماء المتورطين انتماءاتهم الحزبية. قبل أن يجمد سعيد الحياة السياسية ويعرض الانتقال الديمقراطي لأزمة جديدة، كانت معدلات الإصابة والوفاة بفعل كورونا في تونس، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هي الأعلى في شمال إفريقيا ولم يكن سوى 8 بالمائة من السكان قد تلقوا اللقاح. قبل 25 يوليو/تموز 2021، تكررت فعاليات الغضب الشعبي الموجة ضد حركة النهضة والمتهم لقياداتها بالمسؤولية عن البرلمان المستقطب والحكومة العاجزة والفساد المستشري. وقد كانت الفعاليات تلك من بين ما وظف سعيد لاستدعاء المادة 80 من الدستور وحالة الخطر الداهم لتمرير وتبرير إجراءاته.
سياسيا أيضا، خسرت حركة النهضة معظم حلفائها ومن تعاونوا معها في البرلمان والحكومة. انقلبت عليها أحزاب يسار ويمين كانت معها، مثل حركة قلب تونس التي تشكل ثاني أكبر الكتل في البرلمان المجمد وشاركت مع النهضة في تشكيل الحكومة منذ 2019. أما الأهم والأخطر، فهو ابتعاد «الاتحاد العام للشغل» صاحب الدور الوزان في تجربة الانتقال الديمقراطي منذ 2011 عن النهضة واختلافه مع مطلبها المتمثل في إلغاء سعيد لإجراءاته، بل وذهابه إلى حد تأييد الرئيس والتعبير عن الثقة فيه وفي سعيه «لإصلاح النظام السياسي».
بالقطع، لا تسأل حركة النهضة بمفردها عن عوار وسوءات الانتقال الديمقراطي وتدهور أوضاع المجتمع والدولة والناس. بالقطع، تتحمل أحزاب اليسار واليمين، قديمها وجديدها، شقا كبيرا من المسؤولية عن البرلمان المستقطب والحكومة العاجزة وشبهات الفساد والصراعات الكلامية المستمرة في الفضاء العام. غير أن دفع بعض قيادات النهضة، وكعادة أحزاب وتيارات الإسلام السياسي في بلاد العرب في التنصل من المسؤولية والتموضع الفوري في مواقع المظلومية وضحايا الظلم والتآمر، بكون الحركة «بريئة» من الاستقطاب والعجز وشبهات الفساد وبكون السخط الشعبي عليها «مفبركا» من أعدائها واحتجاجات الناس ضدها «ممولة من الخارج» إنما هو تعبير بائس عن إنكار الحقيقة والتورط في سرديات المؤامرة العقيمة. فالثابت هو أن الفضاء العام في تونس يمر حاليا بموجة عاتية رافضة للإسلاميين ولقياداتهم وملقية عليهم بالمسؤولية عن الأوضاع المتدهورة. الثابت هو أن الفضاء العام في تونس يتحرك على إيقاع الغضب من الإسلاميين ومن بوابتهم على إيقاع السخط الشعبي على الانتقال الديمقراطي والبرلمان والحكومة والسياسة والأحزاب. الثابت هو أن الفضاء العام في تونس تحضر بين جنباته أحزاب وحركات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني تؤيد الإجراءات الانفرادية للرئيس قيس سعيد وتثق في نواياه وتصفق لتعقبه للفاسدين ولا تعارض شعبويته التي تجعله يرفض الحوار «إلا مع المخلصين الثابتين» ويتمسك برفض الأحزاب السياسية ككيانات لا شرعية لها هدفها «التربح» على حساب الناس.
إذا كانت إجراءات سعيد وخطابه الشعبوي تعرض الانتقال الديمقراطي في تونس لأزمة حقيقية، فإن إنكار الإسلاميين لمسؤوليتهم واكتفاء قيادة النهضة بالمطالبة بإلغاء تجميد البرلمان وبالحوار الوطني دون ضمانات لسبل عدم العودة إلى البرلمان المستقطب والحكومة العاجزة والفساد المستشري ليس لهما سوى أن يرفعا مناسيب السخط الشعبي على الديمقراطية والسياسة والسياسيين وأن يمهدا المزيد من الأرض لعودة حكم الرجل القوي (البطل الفرد المنقذ) وسط تأييد الناس.
كاتب من مصر
القدس العربي
———————-
المشترك والمختلف بين سعيّد والكاظمي/ عبد الباسط سيدا
ما جرى، ويجري، في تونس منذ بداية ظهور الرئيس قيس سعيّد في المشهد بناء على “الشرعية” الانتخابية (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، يتماثل في أوجه كثيرة منه مع تطورات الوضع العراقي منذ وصول مصطفى الكاظمي (إبريل/ نيسان 2020) إلى رئاسة الحكومة بناء على “شرعية” التوافقات الدولية، خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، من جهة؛ والتوافقات الداخلية من جهة أخرى. وقد أراد أصحاب هذه التوافقات بها كسب الوقت، خشية الوصول إلى مرحلة الصدامات المباشرة المفتوحة التي يبدو أن الأطراف المعنية لم تكن تريدها، أو لم تكن مستعدّة لها.
ولكن هذا التماثل لا ينفي التباينات الكثيرة بين الوضعين، وهي تباينات لها أسبابها الواقعية المفهومة، فما يجمع بين سعيّد والكاظمي أنهما لا ينتميان إلى حزب أو كتلة سياسية؛ وإنما وصلا إلى موقعيهما في ظل انسداد الآفاق نتيجة الصراعات الشديدة حول السلطة بين الكتل السياسية الداخلية؛ هذا مع فرق بين الوضعين التونسي والعراقي في هذا الميدان، يتمثل في أن مؤسسة الجيش، أو بكلام أدقّ الدولة العميقة التونسية التزمت الحياد، حتى ولو في الظاهر، بينما في الحال العراقية تبدو هذه الدولة مفكّكة، موزّعة بين ولاءات متعدّدة مختلفة. ويبدو أن غالبية الشعب التونسي التي قرّرت التصويت لقيس سعيّد إنما فعلت ذلك اعتقادا منها أن ذلك قد يساعد في إخراج الدولة التونسية، والبلاد عموماً، من النفق المظلم. هذا بينما كان الكاظمي حصيلة التوافقات، كما أسلفنا، بين القوى الداخلية والدولية، ولمدة ومهمة محدودتين، وذلك في ضوء ما هو معلن. تتمثل مهمته في ايصال العراق إلى الشرعية الانتخابية التي من المفروض أن يحصل عليها غيره، هذا إذا استمر الالتزام بالتوافقات التي كانت إلى حين اجراء الانتخابات التي من المفروض أنها ستكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يطرح سعيّد نفسه المصلح الذي يريد القضاء على الفساد، وتنظيم شؤون الإدارة. وكذلك يفعل الكاظمي، مع فارق بينهما بطبيعة الحال، فالأول عطل البرلمان المنتخب بناء على تفعيل إشكالي استند إلى تأويل مثير للجدل لمادة دستورية (المادة 80)، وفي غياب المحكمة الدستورية العليا التي كان من المفروض أن تبتّ في أمر الخلاف. بينما يسعى الكاظمي إلى تمرير مشروعه عبر البرلمان، وفي ظل وجود المحكمة الاتحادية العليا التي من صلاحياتها البتّ في القضايا الدستورية.
من جانب آخر، يبدو سعيّد كأنه يواجه الوضع المعقد وحيداً، لكنه يتناغم مع المطالب الشعبية، ويمنح الوعود. والواضح أنه يستند إلى قوة الدولة العميقة، المتمثلة في الجيش والأجهزة الأمنية. وعلى الأغلب، هناك قوى إقليمية داعمة له، وقد عبر بعضها عن ذلك صراحة. والكاظمي هو الآخر يبدو كذلك، لكنه يستمد الدعم من رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يمثل قوة سياسية مؤثرة في الخريطة السياسية العراقية؛ وكذلك وزير الخارجية فؤاد حسين. فالرجلان، إلى جانب مؤهلاتهما وخبراتهما التي يعترف بها الجميع، يحظيان بدعم أكبر حزبين بين الأحزاب الكردية العراقية؛ ولديهما علاقاتٌ واسعةٌ على مستوى القوى السياسية العراقية، وعلى المستويين، الإقليمي والدولي، بصور عامة. كما يستند الكاظمي إلى علاقاته مع فاعلين عديدين في المؤسستين، العسكرية والأمنية، خصوصا أنه كان شخصياً رئيس جهاز المخابرات، ولكنه يظل مثل سعيّد خارج نطاق الكتل السياسية العراقية التقليدية التي تعيش تنافساً، إن لم نقل صراعاً محموماً من أجل الحكم والسيطرة. كما يتكئ الكاظمي، مثل سعيّد، على الحراك الشعبي العراقي الذي يريد هو الآخر محاربة الفساد، وتأمين مقومات العيش الكريم للعراقيين، سواء في ميدان الخدمات، أم الرعاية الصحية، أو التعليم والعمل.
ولكن هذه التماثلات وغيرها لا تنفي وجود تباينات أساسية مفصلية بين الوضعين. نرى في الحالة العراقية أن إيران هي المتغلغلة في مفاصل الدولة والمجتمع العراقيين، وهي تمتلك قوة تأثير كبرى عبر فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بها، والمليشيات الأخرى التي شكلتها، إلى جانب تمكّنها من الوصول إلى مفاصل كثيرة في المؤسسة الأمنية، والحكومة والبرلمان؛ فضلاً عن السلطات المحلية في محافظات عراقية عديدة. وفي سبيل التخفيف من حدّة هذا الوضع، يسعى الكاظمي من أجل مد الجسور مع الدول العربية، وإقناعها بضرورة العودة إلى العراق، والاستثمار فيه، ودعم القوى العراقية الراغبة في إخراج الدولة من دائرة النفوذ المهيمن الإيراني.
على الصعيد التونسي، لا يواجه سعيّد مثل هذا التحدي؛ وهناك دول عربية عبرت عن مساندتها قراراته، في حين أن غالبية الدول العربية أعلنت عن حرصها على أمن الدولة والمجتمع التونسيين وسلامتهما؛ هذا مع ترقبها ومتابعتها لمجريات الأوضاع الداخلية التي لم تستقر بعد.
أما التباين الآخر بين الوضعين فيتمثل في تماسك الدولة العميقة التونسية، إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير، في حين أن هذا الأمر غيرمكتمل في الوضع العراقي؛ لأسباب مختلفة، في مقدمتها نفوذ النظام الإيراني القوي داخل الجيش والمؤسسات الأمنية، وهيمنته الكاملة على فصائل الحشد التابعة له، وتحكّمه بواجهات تلك الفصائل السياسية في البرلمان.
وهناك تباين ثالث يتمثل في الوضع الجيوسياسي لكل من البلدين، فللعراق حدود طويلة مع إيران. وهناك عوامل تاريخية وجغرافية، سياسية وسكانية ومذهبية كثيرة تعقد طبيعة العلاقات بين البلدين، في ظل نظام اعتمد استراتيجية التوسع والاعتداء والتغلغل من أجل البقاء في موقع المتحكّم في الداخل. كما يشترك العراق بحدود وعرة وحسّاسة مع تركيا في الشمال التي تعلن دائما عدم قبولها وجود حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. وقد استخدمت الحكومات التركية المتعاقبة، خصوصا في ظل الحكومة الحالية، هذه الورقة للدخول إلى الأراضي العراقية عبر مناطق إقليم كردستان العراق.
الولايات المتحدة موجودة في العراق دبلوماسياً وعسكرياً، وهي تحظى بدعم قوي من حلفائها من الدول الغربية في حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذا إلى جانب تأثر الوضع العراقي بالوضع السوري، وسعي إيران المستمر إلى استخدام العراق ممراً برّياً للوصول إلى كل من سورية ولبنان، وذلك ضمن إطار استراتيجية التوسّع والتمدّد المشار إليها. ويضفي ذلك كله صعوبات استثناية على مهمة الكاظمي الذي يدرك مسبقاً أنه لن يتمكّن من إنجاز مهمته من دون توافق إقليمي – دولي؛ ومساندة عربية، ودعم داخلي عراقي، سواء من القوى السياسية أو الشعبية.
أما في الحالة التونسية، وبالنسبة إلى وضع سعيّد تحديداً، فتبدو الأمور أسهل نسبياً؛ إذ لا توجد قوات أجنبية على الأرض التونسية. ولكن الصعوبة في أن الهرطقة الدستورية التي اعتمدها الرئيس في إعلان حملته الكبرى على حركة النهضة لا تسعفه لإنجاز مهمته وفق تصوراته، أو ربما وفق خطط من يدعمه، فالدستور الذي أعلن التزامه به لا يمنحه صلاحية حل البرلمان. كما أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج. هناك فساد في تونس، لا أحد ينكر ذلك. والقول إن حزب النهضة لم يكن موفقاً في إدارته تونس (بشراكة آخرين) منذ نحو عشر سنوات، هو الآخر يحظى بموافقة الجميع تقريباً. ولكن الحل لن يتحقّق بالوقوف هنا. هل سيكون هناك حوار وطني عام للوصول إلى توافقاتٍ معنية، حتى ولو ضمن الحدود الدنيا لإنقاذ البلاد، وإبعادها عن مخاطر التدخلات الخارجية؟ أم أن لعبة الشد والجذب والاستقطاب ستستمر، لتكون تونس، في نهاية المطاف، في قبضة انقلاب عسكري، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة؟ ما زالت الأمور متداخلة، والنزعات متعارضة، ولكننا في جميع الأحوال لا نريد سوى الخير والاستقرار للشعب التونسي الذي قاسى كثيراً من الاستبداد والفساد. كما نتمنّى الخير للشعب العراقي الذي عانى، هو الآخر، كثيراً من أنظمة فاسدة مفسدة.
وقد علمتنا تجارب المنطقة، خصوصا في سورية، أن الصراعات الإقليمية والدولية لا تقيم وزناً لتطلعات شعوبها المشروعة، ولكننا مع ذلك نأمل أن تتمكّن القوى الوطنية الفاعلة التي تعلن احترامها لتطلعات هذه الشعوب وتضحياتها، من امتلاك الإمكانات التي تستطيع بموجبها تجاوز المخاطر التي تحيط بها من جميع الجوانب. ولن تتحقق هذ الإمكانات من دون حوارات وتفاهمات داخلية.
وأخيراً وليس آخراً، سواء في الحالة التونسية أو العراقية، بل في حالة معظم دول المنطقة، التحديات التي تواجهها هذه الدول وجودية بنيوية عميقة، يستوجب التعامل الفاعل معها الانطلاق من مشروع وطني جامع، يطمئن إليه الكل من دون اي استثناء.
العربي العربي
———————-
في أسباب ما حدث في تونس/ عمر كوش
جاءت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 25 الشهر الماضي (يوليو/ تموز) تتويجاً لانفجار الأزمة السياسية التي عاشتها تونس منذ أشهر عديدة ما بين أقطاب النخبة السياسية الحاكمة، وتجسّدت في صراع مفتوح ما بين الرئيس سعيّد من جهة أولى، وكل من رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي من جهة ثانية، لكن جذورها وأسبابها تمتد إلى ما تمخّضت عنه انتخابات 2019 من أغلبية برلمانية منقوصة ورئيس دولة جاء من خارج المنظومة الحزبية القائمة، مستنداً إلى حمولةٍ شعبويةٍ معاديةٍ للأطر الحزبية، ومارست قطيعة تامة معها، وأفضى ذلك كله إلى استمرار الأزمة وتفاقمها، وترك آثاراً سلبية عميقة على مختلف مفاصل الدولة والمجتمع، وعلى حياة الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن الفشل في مواجهة فيروس كورونا. غير أن انفجار الأزمة جاء على حساب توجيه ضربة قوية لتجربة الانتقال الديمقراطي الذي أطلقته الثورة التونسية بعد إطاحة نظام زين العابدين بن علي المستبد بداية عام 2011، وبات يهدّد ما سمي الاستثناء الديمقراطي التونسي المحاط بأعداء عديدين في الداخل من قوى الثورة المضادّة، وبأنظمة الاستبداد العربي المقيم في الخارج، والمعادية لأي انتقال ديمقراطي في بلداننا العربية.
والأخطر أن تؤدي إجراءات الرئيس سيعد إلى العودة إلى السلطوية والاستبداد، كونها أفضت إلى تجميع السلطات بيده مع إقالة الحكومة، وتعليق عمل البرلمان. وقد يسفر الأمر عن اتخاذ آلياتٍ من أجل تغيير النظام السياسي، بما يفضي إلى تغيير قواعد الحكم عن طريق اتخاذ مزيد من الإجراءات، لتغيير هوية النخب التي تسيطر على القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وعلى صنع السياسات، خصوصا أن الرئيس سعيّد معروف عنه تذمّره من النظام السياسي التمثيلي القائم، حيث لم يخف ميله إلى تعديل الدستور الحالي، بغية إعادة النظام رئاسياً كما كان عليه ما قبل الثورة. وهناك أمثلة عديدة في دول العالم على التحولات من الديمقراطية إلى السلطوية، مثل فنزويلا خلال فترة حكم هوغو تشافيز والإجراءات التي قام بها الرئيس ألبيرتو فوجيموري في البيرو.
وقد أسهم الصراع بين النخب السياسية الحاكمة في تونس منذ بداية الانتقال الديمقراطي إلى إطاحة عدد من الحكومات، مع بروز أزمة هيمنة فيما بينها في ظل انهيار الاقتصاد التونسي العالق في أزمةٍ مستفحلةٍ مع غياب الإصلاحات المطلوبة، والذي يعبّر عنه تطوّر حجم الدين من 45% من الناتج القومي العام في 2010 إلى حوالي 100% في هذا العام، إضافة إلى انقسام النخب السياسية الحاكمة وتآكل شرعيتها. ومنذ سنوات عديدة، والأوضاع في تونس تسير نحو الأسوأ، خصوصا على مستوى الاقتصاد، وشهدت نشوب معارك سياسية نتيجة الصراع بين نخب إسلامية وعلمانية ما بين 2011 و2013، والتي انتهت بمصالحة هشّة وتوافق على وضع دستور 2014 الذي أسّس لنظام هجين ومختلط، منح الرئيس مسؤولياتٍ أساسية مقابل إعطاء البرلمان صلاحيات واسعة، الأمر الذي نجم عنه صراع جديد بين الرئاسات، وسيادة حال من الفوضى وغياب الرؤى السياسية، أسهمت في تفاقم انهيارات اقتصادية واجتماعية، وغياب دور الدولة في التخطيط التنموي المراعي للتوازنات الطبقية والجهوية، مقابل جنوح مجموعاتٍ وقوى حزبية إلى نهج من الابتزاز والسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة من أجل مصالحها، وتمتين علاقات المصالح مع قوى المال والأعمال وشبكات الفساد، الأمر الذي أسهم في زيادة حدّة معاناة الفئات الوسطى والفقيرة، وعدم حماسها في الانخراط في الفضاء العام، والعزوف عن التفاعل مع متطلبات الانتقال الديمقراطي بعد الثورة، ذلك أن القوى والأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية لم تفرز سوى أجهزة بيروقراطية استشرى فيها الفساد، وتحوّلت إلى جماعاتٍ ريعيةٍ تنهب مقدّرات الدولة، ولا تكترث بمصالح الشعب وحاجاته. لذلك ارتفعت أصوات نقدية داخل الأحزاب القائمة، تطالب قياداتها بالتنحّي وإفساح المجال أمام قيادات شابة جديدة، وتلقي باللائمة على سلوكها وتصرّفاتها وتحالفاتها التي أفضت إلى النكوص في مسار الانتقال الديمقراطي المنشود.
واتسم المشهد السياسي التونسي بعد الثورة بتوازناتٍ ضعيفة وهشّة، حيث جرى التركيز على التسويات السياسية ما بين القوى والأحزاب السائدة، والتوصل إلى توافقاتٍ من أجل الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي، لكن تلك التوافقات والتسويات أضحت عاملاً معطّلاً ومعيقاً، خصوصا في ظل عدم وجود طرف قوي، سواء في السلطة أم في المعارضة، الأمر الذي يفسّر جنوح الصراع الدائر نحو الشخصنة، وعدم القدرة على القيام بمبادراتٍ سياسيةٍ جريئةٍ لإنهاء حالة التعطيل التي شهدتها تونس في مختلف المجالات، فضلاً عن حالة عدم الانسجام بين أحزاب وقوى الائتلاف الحاكم وضعف المعارضة وتفكّكها، وأفضى ذلك إلى استقطاب شديد بين النخب السياسية، وجمود في مجلس النواب الذي تحوّل إلى منصةٍ لكيل الاتهامات وتبادل الشتائم، وإلى عدم تشكيل المحكمة الدستورية المنوط بها الاحتكام والفصل في دستورية كل الإجراءات والتوجّهات المتخذة. وبالتالي، لم يتجسّد الصراع السياسي بين أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، بل في صراع المواقع والصلاحيات بين مؤسسات الحكم الثلاث، الأمر الذي أتاح صعود ظواهر شعبوية، بوصفها تعبيراً عن فشل النخب الحاكمة في تلبية متطلبات حاجات عامة التوانسة، كونهم المتضرر الأكبر من الأزمات السائدة.
وعلى الرغم من أن أغلب الأحزاب والقوى السياسية في تونس ترفع شعار العدالة الاجتماعية، وتدّعي أنها تدافع عن الديمقراطية، لكنها في واقع الأمر تتصرّف وفق توجهات نفعية وتطرح مطالب ضيقة وفئوية، وتمادت في نهجها بشكل أضرّ بالدولة والمجتمع، ويعود ذلك إلى المنطق الذي ساد بين النخب السياسية في تونس بعد الثورة التونسية والذي قام على المحاصصة والتغلب من أجل السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وأفضى إلى نشوء فجوات كبيرة بين هذه النخب والعامة من الشعب التونسي الذين شعروا بالإحباط وخيبة الأمل من الأحزاب والمؤسسات القائمة، وإلى فقدانهم الثقة في الآليات والإجراءات الديمقراطية، بعد أن تمادت القوى الحزبية في مهاتراتها ومماحكاتها.
وعلى الرغم من كل ما حصل من إجراءات غير ديمقراطية في تونس، فإن الأمل يبقى معقوداً على القوى الحيّة في المجتمع التونسي، الحريصة على استكمال عملية الانتقال الديمقراطي، والقادرة على التفكير بواقعية في مسارات بنائها، واستعادة الدعم الشعبي لها عبر الالتفات إلى حلحلة همومه وتحقيق مطالبه في العيش الكريم، وبما يمنع تونس مع العودة إلى الوراء نحو التسلطية والديكتاتورية.
العربي الجديد
——————————
عزمي بشارة: في أخطاء حركة النهضة التونسية
نشر مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، اليوم الإثنين، تعليقاً عبر صفحته في “فيسبوك”، استعرض فيه “أخطاء حركة النهضة” كما سمّاها، وذلك بعد أن بيّن سابقاً منجزات الحركة، من إصلاح فكري، وتمسّك بالديمقراطية، إلى رفض الإملاء الديني القسري والتكيف مع علمانيّة الدولة، والبراغماتية السياسية، والاستعداد لتقديم التنازلات في اللحظات التي بدا فيها الانتقال إلى الديمقراطية مهدداً، وغيرها.
وقدّم بشارة في تعليق بعنوان: “في أخطاء حركة النهضة”، 10 أخطاء سياسية وقعت فيها الحركة، بوصفها حزباً سياسياً ظلّ منذ الثورة جزءاً من الائتلافات الحاكمة المتغيرة، كالآتي:
“1- تمسكت “النهضة” بالسلطة بأي ثمن، حتى حين كان يجب أن تنتقل إلى المعارضة، وحتى حين كان الطريق الوحيد هو بناء تحالفات انتهازية ليس فقط في نظر الجمهور الواسع، بل أيضاً في نظر قواعدها الاجتماعية.
2- كان الثمن الموضوعي للتحالف مع “نداء تونس” المساومة على العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
3- كان على “النهضة” و”نداء تونس” واجب انتخاب محكمة دستورية، فهي ضرورة ماسة في نظام رئاسي/برلماني مختلط. ولكنهما لم يقوما بهذا الواجب، كانت “النهضة” عموماً تشك بالقانونيين والنخب العلمانية، وتخشى تكرار تجربة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
4- كان عليهما تغيير طريقة الانتخابات بوضع عتبة انتخابية ووضع قانون يمنع السياحة الحزبية وتشويه صورة الأحزاب. ولكن استمرار طريقة الانتخابات القائمة أسهم إسهاماً أساسياً في تعطيله.
5- ركزت “النهضة” هجومها في الانتخابات الأخيرة على نبيل القروي إلى درجة شيطنته، وكان المستفيد الوحيد هو المرشح المنافس سعيد الذي لم تنطق ضده بكلمة نقد واحدة، وهو الفاقد لأي برنامج والذي يصرح علناً بمواقف مناهضة للدستور والنظام البرلماني. والأنكى والأمرّ أنها ما لبثت أن تحالفت مع من شيطنته، فبدت بذلك جزءاً من نظام حزبي فاسد لا تهمه المبادئ والقيم بقدر ما تهمه السلطة ومنافعها. خسرت “النهضة” بذلك مرة أخرى جمهوراً سبق أن أيّدها، ولكنها لم تكسب جمهور القروي. وفقدت تبريرات “النهضة” فاعليتها هذه المرة. التحالف مع السبسي (الذي لم يكن بحاجة للتحالف مع النهضة إذ كان بوسعه تشكيل ائتلاف أغلبية في البرلمان من دونها) كان لإنقاذ الانتقال الديمقراطي، فما هو تبرير التحالف مع “قلب تونس”؟ البقاء في السلطة.
6- سبق أن تحالفت “النهضة” مع يوسف الشاهد ضد حزبه وضد من عيّنه (السبسي) ومع ذلك لم تكسبه حليفاً لها، فهو سياسي وصولي لا غير، فاستفاد منها ولم تستفد منه. وحاولت أن تكرر ذلك مع المشيشي، المكلف المجهول الذي أتى به الرئيس، والذي “عصى” من عيّنه وحاول أن يجعل منه مجرد وزير أول في نظام رئاسي، فأدت المحاولة إلى أزمة شلت الدولة طوال عام كامل. حكومة مدعومة من “النهضة” غير قادرة على العمل، رئيس يفعل كل شيء لشل حكومة قامت عكس مشيئته، وبرلمان مشغول بالمناكفات والمشاكسات كما تبدو صورته.
7- لم تكن أجندة سعيد ضد “النهضة” التي دعمته في الجولة الثانية من الانتخابات، فليست هذه معركته الأساسية، بل كانت معركته ضد البرلمان لصالح نظام رئاسي فردي، ولكن سهل عليه تصوير المعركة على أنها معركة ضد الأحزاب والنخب السياسية عموماً (وهذا جوهر الخطاب الشعبوي)، أما التركيز على “النهضة” فيسهل استقطاب فئات واسعة لديها موقف متأصل ضد “النهضة”، وإن كانت غير متعاطفة مع شعبوية الرئيس وتفضل الفرنسية الفصحى على لغته.
8- الغريب أن “النهضة” فوجئت من وجود أجندة مناهضة للنظام البرلماني لدى سعيد، مع أنها كانت معلنة، والغريب أيضاً أنها لم تتمكن من التعامل مع شعبوية سعيد التي لم تتجاهلها فحسب في الانتخابات، بل تعاطفت معها.
9- حين تصدّت “النهضة” لخوض المعركة مع سعيد، لم تدرك مدى سوء صورة البرلمان في الشارع التونسي (هيئة من دون فاعلية في حل قضايا الشعب ومكان للمناكفات والتهريج، وأصحاب المصالح الفردية المتنقلين من حزب إلى آخر)، وكم تدهور وضعها في الشارع. وظهرت “النهضة” وكأنها تمثل صورة الأحزاب المتردية كلها حين أصرت على رئاسة البرلمان، والإصرار على أن يكون رئيس الحركة (وليس غيره) هو رئيس البرلمان، وقيادة ائتلاف يدعم حكومة معطلة. ولو كانت في المعارضة لكانت في وضع أسلم بكثير، ولو بقي رئيس الحركة خارج هذه المعمعة لكان أفضل له وللحركة.
10- ارتكبت الأحزاب الكبيرة الأخرى أخطاءً أكثر فداحة بالتأكيد، ولكن “النهضة” كانت الحزب الثابت في الخارطة التونسية منذ الثورة، والأكثر تواجداً في السلطة، وإليه وجهت سهام الخطاب الشعبوي.
العربي الجديد
—————————
قيس سعيّد وحلم النظام الرئاسي: قوننة حكم الفرد/ وليد التليلي
لم يُخفِ الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ وصوله للرئاسة أواخر العام 2019، مناهضته للنظام السياسي القائم في البلاد، مروّجاً مراراً للنظام الرئاسي، ليفتح معركة مع البرلمان صوّرها كمعركة ضد الأحزاب والنخب السياسية، وتوّجها بتعليق عمل البرلمان في قراراته الانقلابية التي أعلنها مساء 25 يوليو/تموز الماضي، وفق ما قال إنه الفصل 80 من الدستور. أتبع سعيّد ذلك بقرارات وتعيينات وتوجيهات لمسؤولين في قطاعات حيوية، هي من اختصاصات رئيس الحكومة في النظام الحالي، غير أنها في جوهر أعمال رئيس الدولة في نظام رئاسي خالص. وبذلك، يبدو سعيّد وكأنه في حملة انتخابية تسبق الاستفتاء على النظام السياسي، مروّجاً لفشل النظام القائم، مقابل فعالية النظام الرئاسي وسرعة اتخاذ القرارات ونجاعة التدخل على عكس ما كان يحدث مع البرلمان والحكومة المعطلة والخلافات السياسية، مقدماً مثالاً على ذلك النجاح في تلقيح فئات واسعة من الشعب وتقليص خطورة وباء كورونا. لكن في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتعليق عمل البرلمان مع غياب المحكمة الدستورية، تُطرح تساؤلات عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها سعيّد للمرور إلى النظام الرئاسي الصرف، ومدى دستورية ذلك في الأجواء الراهنة.
وسعى سعيّد منذ تسلّمه الحكم لتحميل النظام القائم مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة التي شهدتها البلاد. وخلال زيارة إلى مدينة قابس جنوب البلاد لمعاينة حريق في أحد المصانع في مارس/آذار الماضي، وجّه الرئيس التونسي انتقادات للنظام البرلماني الذي تعتمده تونس منذ العام 2014، قائلاً: “لو كان نظام الحكم في تونس رئاسياً، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار”. وردد الكلام نفسه تقريباً عندما دعا في يونيو/حزيران الماضي إلى قصر قرطاج رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وعدداً من رؤساء الحكومات السابقين، ودعا إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إن “كله أقفال”.
أستاذة القانون الدستوري منى كريم، شرحت في حديث مع “العربي الجديد”، طبيعة النظام الحالي في تونس قائلة إنه ليس نظاما برلمانيا صرفا ولا نظاماً رئاسياً صرفاً بل هو نظام مزدوج أو برلماني معدّل. وأوضحت أنه في الأنظمة البرلمانية لا يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر ولا يحظى بصلاحيات هامة كما في الوضع التونسي، ولا يقاسم رئيس الحكومة الصلاحيات، كما أنه في أعراف الأنظمة البرلمانية العريقة يقود الحكومة الحزب الأغلبي في البرلمان، وعادة ما يكون زعيم ذلك الحزب أو الائتلاف البرلماني، أما الرئيس فيُعيّن من البرلمان أو ينتخبه، وتكون صلاحياته الدستورية فخرية أو رمزية بتعيين رئيس حكومة يختاره ائتلاف البرلمان أو إبرام اتفاقات أو بعض الضمانات الدستورية.
أما في الأنظمة الرئاسية، وفق كريم، فإن الرئيس يمتلك صلاحيات تسيير الجهاز التنفيذي واقتراح القوانين والتشريعات، وهو يعيّن وزيراً أول أو رئيس وزراء لمساعدته في تنفيذ سياساته، وتكون صلاحيات الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب، واسعة، ويكون دور البرلمان رقابياً على الرئيس والحكومة، ويُعتبر البرلمان ضمانة، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا التي تراقب الرئيس ومدى دستورية قراراته. ولفتت إلى أن رهان الدساتير في الأنظمة الديمقراطية هو تجسيد التوازن بين السلطات والفصل بينها وتجسيد حكم الشعب عبر ممثليه ومن يختارهم للحكم، موضحة أن تحقيق الديمقراطية هو ما يميز بين النظامين الرئاسي والبرلماني وكلاهما جيد إذا ما حقق ذلك، فيما الاختلاف يكمن في الممارسة.
لكنها أشارت إلى أن الهواجس والمخاوف من النظام الرئاسي في تونس تعود إلى فترة ما قبل 2011، إذ كان واضعو الدستور يخشون العودة بالبلاد إلى نظام رئاسوي، في وقت يمكّن النظام البرلماني من تمثيل أوسع ومشاركة أكبر للمعارضة، معتبرين أن الحكم البرلماني ضمانة ضد عودة الاستبداد أو الانحراف بالحكم، فيما يعتبر مناصرو النظام الرئاسي أنه أكثر قوة وصرامة وسرعة في التنفيذ وهو ما تحتاجه البلاد للمسارعة بالخروج من الوضع.
ورأت كريم أن المرور من النظام الحالي، إلى النظام الرئاسي الصرف أو البرلماني الصرف، يكون عبر تعديل الدستور الذي ينظّم صلاحيات كل سلطة والعلاقة بينها، ولكن في الوقت الحالي من غير الممكن تعديل الدستور، كما ينصّ الدستور نفسه، بسبب تعليق البرلمان، المسؤول عن التعديل الدستوري الذي يمكن أن يقترحه الرئيس أو النواب، كما لا يمكن ذلك أيضاً بسبب عدم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية التي يشترط أن تراقب مدى دستورية هذا التعديل وعدم الانحراف به.
ولفتت إلى أنه في الوضع الاستثنائي الحالي وفي غياب محكمة دستورية وتعليق البرلمان يمكن أن يستند الرئيس إلى تدابير استثنائية من خارج الدستور الحالي معتمداً على المشروعية القانونية والشعبية بأن يطرح استفتاء لتغيير النظام السياسي. وبيّنت أن إصدار مرسوم منظم للسلطات العمومية يجسد النظام الرئاسي بدلاً عن الدستور هو إجراء لادستوري باعتبار أن الدستور يشترط إصدار مراسيم في حالة حل البرلمان وليس تجميده أو تعليق أعماله، ويمكن للرئيس ذلك بعد حله نهائياً، مشيرة إلى أنه لا يمكن في الحالة الاستثنائية تعديل الدستور عبر أوامر رئاسية.
أمام هذا الواقع، ينتظر التونسيون أن يفصح سعيّد عن نواياه، أو بالأحرى عن كيفية تنفيذ توجهاته، وهو قال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت الماضي إنه سيكشف قريباً عن خريطة الطريق للفترة المقبلة و”سيواصل إيلاء الشرعية الشعبية ما تستحقه من مكانة وأهمية”. ويحيل التشديد على “الشرعية الشعبية” في هذا البيان إلى أن سعيّد ماضٍ في برنامجه معتمداً أساساً على هذه الشرعية. وعن ذلك، قال رئيس “الكتلة الديمقراطية” المعارضة، نعمان العش، في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”: “نحن في حالة تعليق للدستور غير معلن، قف انتهى”.
ومتخلصاً من أعباء البرلمان، وقيود الدستور باعتبار الحالة استثنائية، واختفاء المعارضة وعدم معارضة ما يقوم به من قبل جزء من الشعب، يتصرف سعيّد بأريحية كبيرة في وضع برنامجه خطوة بخطوة، إذ عيّن مسؤولين على الوزارات لم يسمهم وزراء، بل مكلفين بتسيير الوزارات، وهي المالية والداخلية وتكنولوجيا الاتصال والصحة، وذلك قبل اختيار رئيس وزرائه (الدستور التونسي يتحدث عن رئيس حكومة وليس رئيس وزراء أو وزيراً أول، لأن تلك تسميات في نظام رئاسي). وعلى امتداد الأسبوع الماضي، استقبل مسؤولين عن قطاع الحبوب والصيدليات والمياه والبنوك ورجال الأعمال وغيرهم، داعياً إلى تقليص الأسعار وتسهيل الحياة على المواطنين، وهي من اختصاص رئيس الحكومة في النظام البرلماني الحالي.
وعن ذلك، رأى أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث مع “العربي الجديد”، “أننا نعيش في جوهر النظام الرئاسي، ولكن هذا محدود بمدة ثلاثين يوماً، وسعيّد يحاول أن يزيل مكامن التعطيل في الإدارة التونسية”. ولفت إلى أن “سعيّد بصدد بعث رسالة للتونسيين بأن النظام السياسي السابق هو نظام فاشل وعاجز ويجعل القرار السياسي رخواً، ولكن عندما تم تجميع قرار السلطة أصبح أكثر نجاعة وسرعة في المتابعة والمحاسبة”.
واعتبر الخرايفي أن “النظام الرئاسي أكثر نجاعة وقوة وصرامة، وكنتُ من مناصريه عندما كنت نائباً في المجلس الوطني التأسيسي، لأن تفتيت السلطة وتوزيعها وحكم الأحزاب، غير الناضجة خصوصاً، يضعف الدولة”، مشيراً في المقابل إلى أن “هناك تفهماً للمخاوف من النظام الرئاسي على الحكم، إلا أنه بوجود ضمانات وآليات قوية تُمنح لبرلمان يتكوّن من أعضاء نزهاء أكفاء يمكن مراقبة الحكم”. وأشار إلى أن “هذه المرحلة تشهد تحوّلات عميقة، جاءت لكنس الطبقة السياسية لـ2011 وما خلّفته، ولكن هناك إشكالاً وخطراً يتمثل في أن حركة 25 يوليو لم تفرز قيادات ومفكرين سياسيين ومنظّرين وقانونيين، بل أفرزت رئيساً للجمهورية فقط، مستعيناً بالإدارة”.
من جهته، أكد المحلل السياسي شكري بن عيسى، لـ”العربي الجديد”، أن “طبيعة نظام الحكم الحالي هو نظام الحالة الاستثنائية، تم التنظير له من كارل شميت وجورجيو أغامبين، وهو نظام لا قواعد دستورية له وتحكمه وضعية الضرورة، أي أن كيان الدولة في خطر، ما يتعطل معه السير العادي لكل سلطات الدولة”. واعتبر أن “الوضع الحالي هو استبدادي، أي أعلى درجة من النظام الرئاسي المحض، فالرئيس يجمع كل السلطات في يده، ناهيك عن أنه لم يسمح باستمرار البرلمان”. وشبّه بن عيسى طبيعة الحكم في تونس في هذه المرحلة “بالسلطات المطلقة وكأنها سلطات إلهية تقارب النظام الثيوقراطي بما جعل الرئيس تجسيداً للأمة وللدستور”، مشيراً إلى أن سعيّد بالغ في استخدام الفصل 80 حتى أصبح هو الفصل 80 نفسه، فحلّ الحكومة وعلّق البرلمان ورفع الحصانة، وهي سلطة ثيوقراطية أعلى عشرات المرات من النظام الرئاسي الذي يفصل بين السلطات، ويكون القضاء مستقلاً والصحافة تعدل وفيه كل الضمانات، بينما اليوم لا توجد أي ضمانات، بحسب رأيه.
ورأى بن عيسى أنه “بسبب الفاعلين السياسيين الذين حكموا البلاد، وعدم كفاءتهم السياسية والاقتصادية والقانونية في كل المجالات، بدا أن النظام البرلماني فشل، خصوصاً مع التأزم الصحي الأخير بفقدان حوالي 20 ألف تونسي بسبب كورونا”، معتبراً أن “النظام البرلماني في نسخته التونسية وفي تطبيقه أثبت أنه لم يعد يصلح، ورئيس الجمهورية منذ ترشحه مقتنع بأن الرئيس لا يمكن أن يكون بلا صلاحيات”.
وشدد على أن سعيّد يؤمن “بأن الرئيس يجسد الأمة وجاء لتحقيق إرادة الشعب والإرادة العامة في شخصه وبالتالي يجب أن تكون له سلطات وصلاحيات واسعة”، منتقداً “تدخّل الرئيس في تفاصيل وجزئيات، وهي على أهميتها لا تفيد، من خلال التدخّل في تخفيض أسعار المواد الغذائية وأزمة المياه والغذاء والتدخّلات في الأدوية والبنوك”، مشيراً إلى أنه “يجب أن تكون للدولة سياسات عمومية في كل المجالات المالية والصحة والاقتصاد”. وشدد بن عيسى على أن “هذا يثبت أنه ليست لسعيّد سياسات ويؤكد أنه في ورطة من خلال تجربة هذا النموذج الذي يفكر فيه وفي تجسيد التصور الرئاسي الذي يبحث عنه”.
العربي الجديد
————————-
الغنوشي في مقال بصحيفة الإندبندنت: الرئيس التونسي استولى على السلطة وأدعوه للتراجع عن حافة الهاوية
عربي بوست
دعا رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الرئيسَ التونسي قيس سعيّد للتراجع عن “حافة الهاوية”، والمشاركة في الحوار، محذراً من أنّ شرعية ثورة 2011 قد صارت في خطر.
في مقال رأي نشره الغنوشي بصحيفة The Independent البريطانية، الثلاثاء 10 أغسطس/آب 2021، اتّهم زعيم حركة النهضة، الرئيس بـ”الاستيلاء على السلطة، بطريقة تُعرّض رحلتنا الهشة والناشئة تجاه الديمقراطية للخطر”.
الأسبوع الماضي قال الرئيس التونسي إنه لا عودة إلى الوراء، ولا حوار إلا مع من وصفهم بـ”الصادقين”، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين انتقدوا قراراته بالسيطرة على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، ووصفها البعض بالانقلاب.
أصعب أزمة سياسية منذ الثورة
إذ أدخل الرئيس قيس سعيّد البلاد الشهر الماضي في أصعب أزماتها السياسية منذ عقدٍ كامل، حين أقال رئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والعدل، وجمّد البرلمان. كما نُشِرَ الجنود حول مبنى البرلمان لمنع أعضائه من دخوله، وحُظِرَت التجمعات الكبيرة.
فقد وصف العديد من الخبراء وأشد منتقدي الرئيس -خاصةً في حركة النهضة- تلك الخطوات الدراماتيكية بأنّها “انقلاب”.
لكن سعيد استنكر هذا الوصف بشدة قائلاً إنّه يستجيب لمطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع قبل الأزمة، ودعوا إلى استقالة رئيس الوزراء وحلّ البرلمان، وذلك في أعقاب الاستجابة الكارثية للجائحة والأوجاع الاقتصادية.
صحيفة The Independent البريطانية قالت إنها تواصلت مع مكتب الرئاسة، لكنّها لم تحصل على ردٍّ فوري.
دعوة جديدة للحوار
كتب راشد الغنوشي: “رفض الرئيس حتى الآن دعواتنا للحوار، لكنَّنا نأمل أن تسود الحكمة في النهاية، ندعو الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن حافة الهاوية، والانخراط في حوار ومشاركة سياسيين حقيقيين شاملين”.
كما قال راشد الغنوشي إنَّ هذا يجب أن يتضمَّن إلغاء تعليق البرلمان، وتسمية رئيس وزراء وحكومة يصوت عليهما البرلمان الذي يجب استشارته بشأن الإصلاحات السياسية.
رئيس البرلمان التونسي أضاف: “تنطفئ الديمقراطية التونسية، منارة الأمل للعالم العربي، بنمطٍ مألوف تماماً أمام أعين المجتمع الدولي. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.
لطالما بُشِّرَ بتونس باعتبارها قصة نجاح انتفاضات الربيع العربي في 2011، التي شهدت الإطاحة بالرئيس التونسي الذي حكم طويلاً زين العابدين بن علي، لكنَّها منذ ذلك الحين تنتقل من أزمة إلى أخرى.
قيس سعيّد يرفض الحديث عن انقلاب
عانت تونس من ارتفاع البطالة، التي تزايدت على مدار العام الماضي من الجائحة لتصل إلى نحو 18% في المتوسط و40% بين الشباب. وتلقى قطاع السياحة في البلاد ضربة كبيرة بعد هجمات متكررة من جانب ما يُسمَّى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
نفى سعيد، وهو محامٍ دستوري سابق، بشدة، تحريضه على انقلاب، وقال إنَّه مضى قدماً بالإجراءات استجابةً لدعوات الشارع.
بينما كان معظم الغضب في الاحتجاجات التي عمَّت أرجاء البلاد وصولاً إلى التعليق المثير للبرلمان مُوجَّهاً نحو النهضة، التي تملك الكتلة الأكبر في البرلمان. وجرى اقتحام مكاتب النهضة ومقراتها المحلية، بل وأُضرِمت النار فيها خلال المسيرات.
فيما نفى راشد الغنوشي أن يكون سعيد تحدث إليه عن الإجراءات، لم يقل رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي شيئاً في أول الأمر، لكنَّه قال لاحقاً إنَّه لن يكون “عنصراً مُعطِّلاً أو مشكلة”، وإنَّه سيسلم السلطة “متمنياً كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد”.
نبرة “أكثر تصالحية” من راشد الغنوشي
فقد نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، يوم الخميس الماضي، 5 أغسطس/آب، صوراً للمشيشي في أول ظهور علني له منذ إقالته في 25 يوليو/تموز.
حسب الصحيفة البريطانية، بدا أنَّ صور هيئة مكافحة الفساد، التي نُشِرَت على موقعها، ترمي لتبديد التقارير غير المؤكدة التي تحدثت عن كونه قيد الإقامة الجبرية.
لكنَّ الغنوشي استخدم في مقاله نبرة أكثر تصالحية، ومن اللافت أنَّه تجنَّب استخدام كلمة “انقلاب” ولم يدع المجتمع الدولي للتدخل بأي شكل.
حذَّر من “الديكتاتورية” بسبب ما قال إنَّه اقتحام مكاتب وسائل الإعلام، وإقالة الوزراء والولاة، والقيود على وسائل الإعلام، وفرض منع سفر بالجملة على القضاة والمحامين والسياسيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني.
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كتب: “لا يمكننا أن نسمح بأن تؤدي هذه التحديات إلى ديكتاتورية أخرى. قدَّم عدد لا يُحصى من التونسيين أرواحهم وضحّوا لبناء نظام ديمقراطي يمكنه حماية الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة”.
—————————–
بين عزمي بشارة وسيمور ليبسيت: تونس لماذا الآن؟/ رفقة شقور
تعد مراحل الانتقال الديمقراطي حتى تصبح الديمقراطية جزءاً من المكونات الوطنية للدولة، من أهم المراحل وأخطرها في النظم التي تنتقل من قمعية ديكتاتورية متغلغلة في أجهزة الدولة العميقة إلى ديمقراطية بفعل الثورات، وتلعب عدة عوامل أدواراً مهمة في سبيل تحول النظام من ديكتاتوري قمعي إلى ديمقراطي.
واجهت الدول العربية التي قامت فيها الثورات مجموعة من التحديات والمخاطر في مرحلة التحول الديمقراطي، ولم يصمد أمام تلك التحديات من تلك الدول سوى تونس حتى إعلان الرئيس التونسي في ٢٦ من تموز /يوليو ٢٠٢١ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مثلت حالة من الانقلاب الدستوري، وتجميع السلطات كلها بين يديه بعد تعطيل البرلمان والسيطرة على القضاء.
من أجل فهم الأسباب التي تقف وراء عملية تسهيل الانقلاب الدستوري في النموذج الديمقراطي العربي الوحيد في تونس، لا بد من الوقوف على مجموعة العوامل التي تسهم في عمليات الانتقال الديمقراطي من أجل فهم مواطن الخلل التي أدت إلى الانحراف عن المسار الديمقراطي:
أولاً- ثقافة النخب السياسية: عد سيمور مارتن ليبسيت الثقافة السياسية للشعوب في نظريته حول التحديث الديمقراطي، من أهم الأسباب والعوامل التي تقف وراء إنجاح أو فشل عمليات الانتقال الديمقراطي، لكن عزمي بشارة المفكر العربي عد أن الثقافة السياسية للنخب السياسية هي التي تتحكم في إنجاح عمليات الانتقال الديمقراطي، وأن الثقافة السياسية للنخب هي التي تؤثر في الثقافة السياسية للشعوب، ورأى بأن النخب السياسية في تونس اعتمدت على التسوية والتقريب مع الخصوم في الدورات الانتخابية الأولى والثانية، وهذا ما ميزها عن التجربة المصرية حيث مالت الحركة الإسلامية التونسية للتنازل عن الحكم خوفاً من تكرار تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وأبدت مرونة في ذلك، وتوصلت لتوافقات مع التيارات المختلفة.
لكن في فترة حكم قيس السعيد عاشت تونس أزمة في الحياة الحزبية، وبرزت أكثر حالة التشظي في الأحزاب التونسية، وفقد الشعب التونسي جزءاً كبيراً من ثقته في تلك الأحزاب ونزع الشعب التونسي لعدم المشاركة في الحياة السياسية، تترجم ذلك عبر عمليات عزوفه عن التصويت في الانتخابات في الدورات الانتخابية الثانية والثالثة، وهذا السلوك السياسي شائع لدى الجماهير التي أصبحت الديمقراطية جزءاً من مكونات الدولة الوطنية فيها، لا لجماهير الديمقراطيات حديثة العهد كتونس، حيث من المفترض في الديمقراطيات حديثة العهد أن لا تسود حالة من التعب السياسي بين الجماهير وأن تكون الجماهير ذات طابع حماسي أكثر للمشاركة في العملية السياسية كي تضمن تثبيت دعائم الحكم الديمقراطي، إلا أن هذا ما لم يتحقق في النموذج التونسي بسبب خيبة الجماهير من النخب السياسية، وبسبب الثقافة السياسية للجماهير والنخب على حد سواء.
تميزت الثقافة السياسية للنخب السياسية في تونس في مرحلة قيس السعيد بخاصة العلمانية الراديكالية المتطرفة منها بأنها أصبحت عامل إعاقة وليس عامل توفيق في الحياة السياسية، ووصلت تلك الإعاقة إلى مخاطبتهم الجيش بالتدخل وكانوا على استعداد لتحمل نتائج انقلاب عسكري على مضيهم في عملية توفيق بين الأحزاب.
أسهمت تلك الثقافة السياسية للنخبة الراديكالية العلمانية بتأزيم المشهد، واستغلال قيس السعيد لحالة التشظي الحزبي، وسوء الأداء الحزبي للأحزاب التونسية في مجمل الحياة السياسية كمدخل لعملية الانقلاب الدستوري، وتمرير ذلك الانقلاب في أجواء ترحيب من الجماهير التي فقدت ثقتها في أداء الأحزاب التونسية، فكما يرى سيمور مارتن ليبسيت بأهمية الثقافة السياسية للشعب في عملية التحول الديمقراطي وتثبيت دعائم الحكم الديمقراطي يلاحظ أن هذا العامل لم يتوفر في الحدث الأخير حيث عكس الترحيب الشعبي والردود الشعبوية المتزايدة على عملية الانقلاب حالة تردي في الثقافة السياسية ضمن شرائح واسعة لدى الشعب التونسي، الذي لم يدرك حجم خطورة الانقلاب الدستوري على نسف مسار الديمقراطية التونسية الناشئة، هذا إلى جانب تردي الثقافة السياسية للأحزاب التونسية، وجنوح معظمها لعدم الاستعداد للمضي ضمن خطوات توافقية فيما بينها تساعدها للضغط في تعطيل الإجراءات الانقلابية الدستورية من قبل قيس السعيد، مما أبطأ في عملية الرد على الإجراءات الانقلابية التي ما زالت الفرصة أمام الأحزاب التونسية والشعب التونسي متاحة من أجل تعطيلها.
ثانياً- الجيش: حسب الباحثين فإن الجيش التونسي لعب أدواراً محايدة لمدة عقود طويلة في حالات النزاعات السياسية الداخلية التونسية، وكان أحد أسباب نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس وفشلها في نظيراتها العربية كمصر، هو أن الجيش التونسي لم يكن له مطامع في السلطة مثل الجيش المصري مثلاً، فقد كان الجيش التونسي عاملاً أساسياً في إنجاح الثورة التونسية بسبب عصيانه أوامر قمعها، ثم حياده التام في مرحلة التحول الديمقراطي، حتى بدا واضحا خلال الأيام الماضية أن قيس السعيد نجح في استمالة قيادات الشرطة والجيش التونسي لصالح إجراءات الانقلاب الدستوري، حين ظهرت قوات من الجيش التونسي أمام البرلمان التونسي من أجل منع البرلمانيين التونسيين من عقد جلساتهم بناءً على مرسوم قيس السعيد الانقلابي، وهذا تحول في دور الجيش التونسي وعامل مهم في طمأنة الرئيس أنه لن تكون خطوات معادية لإجراءاته من قبل الجيش.
ثالثاً- العامل الخارجي: تتمثل أهمية العامل الخارجي في حال كانت الدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي مهمة جيو استراتيجياً، أم لا، وحسب موقع تونس فإنها بمقاييس أهمية الدول العربية جيو استراتيجياً بالنسبة للدول العظمى فإنها تعد غير مهمة ونشوء ديمقراطية فيها لا يهدد تلك الدول، فلا وجود للنفط في تونس، ولا حدود لها أيضاً مع إسرائيل، لذلك لم تأبه الدول العظمى لديمقراطية تونس الناشئة خلافاً لما حصل في مصر وسوريا.
إلا أن الدراسات الديمقراطية الكونية التي تعالج عمليات الانتقال الديمقراطي، والتي رجحت سيناريو نجاح عمليات التحول الديمقراطي في تونس في البدايات، لم تلتفت لأن الدول العظمى ليست اللاعب الخارجي الوحيد في اعتراض المسار الديمقراطي بالنسبة لتونس، فبعد عقد من عمليات الانتقال الديمقراطي والدورات الانتخابية التي عاشتها تونس، في ظل مشهد عربي إقليمي ديكتاتوري، بدأت تؤرق أكثر دول الثورات المضادة والأنظمة القمعية الديكتاتورية التي عرتها تلك الإجراءات الديمقراطية، حيث اتجهت أنظار الشعوب العربية للتجربة التونسية في العملية الديمقراطية، وبدا المشهد حيث لا يمكن التنبؤ من خلال الانتخابات بالنتائج الرئاسية في جو تنافسي ديمقراطي مشهدا صادما، في محيط عربي يحصل فيه الرؤساء على نسب تتجاوز ال 90 في المئة في كل دورة انتخابية، وهذا ما جعل دول الثورات المضادة تغتنم فرصة وجود شخصية مثل قيس السعيد، الذي لم تفلح المظاهر التقشفية الأولى له في الحكم من إخفاء نرجسيته ونزعته الاستبدادية وعدم إيمانه بالديمقراطية، خاصة وأنه صرح في أكثر من لقاء أنه لم يمنح صوته الانتخابي لأي من المرشحين في الدورات الانتخابية التي سبقت الدورة الأخيرة التي أفرزته رئيساً، وظهر الرئيس التونسي بعدها بمظاهر مختلفة أوضحت حجم التحول على الصورة التي قدمها للجماهير التي انتخبته، وفي ظل هذا المحيط العربي الذي يقتنص الفرص من أجل عدم تمكين الإسلاميين خصوصاً في أي نظام ديمقراطي تبدت الظروف كاملة أمام تدخل دول الثورات المضادة لمساعدة قيس السعيد على إقصاء خصومه السياسيين بانقلاب دستوري.
لم تتردد قوى الثورات المضادة في استغلال حالة الاستقطاب الشديد الطارئ بين القوى العلمانية الراديكالية التونسية والقوى الإسلامية، كذلك استخدامها لبقايا النظام الاستبدادي البائد من وسطاء لها في أجهزة الدولة العميقة المعادية للديمقراطية، التي لم تفلح ثلاث دورات انتخابية في القضاء عليها، كل هذا حصل ضمن توظيف خارجي لحالة التردي في الاقتصاد التونسي، ومشكلات الريف التونسي وتراجع عمليات التنمية الاقتصادية في الجنوب التونسي، كذلك عمليات الفساد الواسعة والمخاطر التي ترتبت على انتشار الوباء والخيبة الشعبية الواسعة من الأداء الحكومي، كل هذه العوامل صنعت بيئة خصبة ومغرية لقوى الثورات المضادة للانتعاش من جديد وتوجيه ضربتها للنموذج الديمقراطي التونسي، الذي أصبح يشكل خطراً على محيطه العربي الديكتاتوري، لأنه لافت وجاذب لأنظار الأمة العربية، وخوف قوى الثورات المضادة من أن تصبح ديمقراطية تونس جزءاً من هوية تونس الوطنية، وهذا بحد ذاته يؤزم تلك الأنظمة الديكتاتورية في حال ثبتت الحركة الإسلامية التونسية دوراً بارزاً لها في حكم نظام عربي، فهذا يحرج تلك الأنظمة التي تصور الإسلاميين عموماً على أنهم عدو التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مجتمعاتها.
وهنا أضيف على أهمية العامل الجيو استراتيجي بالنسبة لتونس أنها ضمن محيط دولة الاحتلال الإسرائيلي، وليس من الأهمية أن تشترك معها بحدود حتى تتنبه دول الثورات المضادة لخطورة قيام نظام ديمقراطي فيها، بخاصة تلك التي وقعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيات سلام وتحالف حديثة، فبالنسبة لدول الثورات المضادة وجود ديمقراطية عربية ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال، ويتم انتخاب رئيسها وحصوله على مقبولية شعبية على خلفية رفضه للتطبيع مع دولة الاحتلال أمر يعريها أمام شعوبها، التي في معظمها ترفض التطبيع، في الوقت الذي راحت فيها الأنظمة الحاكمة نحو خيار التطبيع والتحالف مع إسرائيل، وبروز عامل التطبيع مؤخراً ومقدار أهميته لدول الثورات المضادة المتحالفة مع إسرائيل، أدى إلى انتهازها فرصة الأزمات الداخلية التونسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل توجيه ضربتها للحياة الديمقراطية فيها.
رابعاً- الإسلاميون: بالإمكان إضافة هذا العامل إلى جانب العوامل المهمة في عمليات التحول الديمقراطي، استناداً إلى أهميته وخصوصيته في المشهد السياسي التونسي، وقد يفيد دراسة هذا العامل في الدراسات الإقليمية لعمليات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية والإسلامية، فعملية تهميش هذا العامل في الدراسات الديمقراطية الإقليمية لفقر التجربة العربية البحثية في التركيز على هذا الجانب وعدم التطرق البحثي له، حيث أثبت الإسلاميون في فترات الانتقال الديمقراطي حالة من البراغماتية السياسية التي كانت تأمل أن تجر عليها مكاسب تكتيكية دون النظر إلى تأثيرات تلك البراغماتية السياسية في خدمة استراتيجياتها، وأدت لخسارتها لجزء كبير من شعبيتها في الشارع التونسي بسبب السياحة الحزبية بين أفراد جزء كبير من تلك التنظيمات.
تركيز تلك النخب على عبور التحديات المرحلية عبر عمليات السياحة الحزبية والتحالفات البراغماتية أدى لغياب منجز سياسي حقيقي لها، وهذا بحد ذاته شجع قوى الثورات المضادة لمحاولة الإجهاز على حضور الحركات الإسلامية في المجال العام التونسي بخاصة حزب النهضة في إطار حرصها على إفشال حضور الإسلام السياسي في المجال العام العربي عموماً، واستغلت في سبيل ذلك النزعة الانقلابية لدى قيس السعيد لتصفية حركة النهضة سياسياً.
يعد ما حصل مؤخراً في تونس مقياساً لحالة الإحباط الشعبي من الحياة السياسية، ففي ظل غياب ثقافة شعبية سياسية، ورغبة لدى الجماهير في الانخراط في العمل السياسي، وتحول المشاعر السلبية لدى الجماهير من الأحزاب، لترحيب جماهيري شعبوي بإجراءات قيس السعيد الانقلابية، وفقدان الجماهير للحماسة التي تميز الجماهير في الديمقراطيات الناشئة من أجل حل المشكلات السياسية الداخلية الطارئة بالطرق الديمقراطية، لا يمكن عد الانقلاب الدستوري التونسي أزمة تفضي لتسويات داخلية، وإنما قد يتم الإجهاز على الحياة الديمقراطية بشكل كامل في حال لم يكن هنالك مجال عام، ورغبة لدى الجمهور التونسي للإسهام في تصويب المسار الديمقراطي، حتى لو كانت هنالك توافقات داخلية داخل الأحزاب التونسية، تفضي لتآلفها ضد تلك الإجراءات، إلا أنه في الحالة التونسية الحالية، يلعب الشعب التونسي العامل الأهم من الجيش والتدخل الخارجي والأحزاب في عملية ضبط بوصلة المشهد الانقلابي الأخير نحو المسار الديمقراطي من جديد، فحالة الإنكار الشعبي بأن ما قام به قيس السعيد انقلاب دستوري، قد تعمق ركائز الثورة المضادة بغطاء شعبي، ونجاح أي استرداد للحياة الديمقراطية مستند بشكل كبير على استرداد الشعب التونسي لحماسته من أجل المساهمة فيما يحدث لصالح الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
تلفزيون سوريا
————————-
صور الرئيس والأنظمة في تونس وصناعة الديكتاتور/ كمال الرياحي
تونس هو البلد العربي الوحيد الذي لا تجد في شوارعه صورة لرئيسه ولا صورة له في أي مؤسسة رسمية، فقد استبدلت المؤسسات العامة صورة الرئيس بالعلم منذ انتفاضة 2011. ومازالت تلك آخر علامات الديمقراطية في تونس بعد أن أكلتها الأحزاب وأعلامها. غياب صورة الرئيس المفدى كان مبعث أمل دائم أنه بإمكان الشعب أن يسترد حلمه في بناء ديمقراطية حقيقية.
صور الرئيس في المزبلة
كان أول ما قام به التونسيون في انتفاضتهم عام 2011 هو التخلص من صور الرئيس ورميها في القمامة. بعض المسؤولين كان حذراً، فذهب إلى إخفائها تخوفاً من عودته. جُمعت كل صور الرئيس والكتب الحزبية والأعلام لكي تُدفن في مخازن المؤسسات.
وعندما ظهرت صور الوجوه السياسية على الجدران، كصور الغرافيك للباجي قايد السبسي، التي رافقتها عبارة “لا يمكن أن أحلم مع جدي”، ظهرت معها عبارات تحذّر من إعادة صناعة الدكتاتور. مثّلت هذه الظاهرة الفنية خاصة جماعة “أهل الكهف”، واستبدل الفنانون في تونس صور السياسيين بصور الكتّاب في الشوارع: إدوارد سعيد، محمد شكري، صامويل بيكيت وجيل دولوز…
وشيئاً فشيئاً غابت حتى صور محمد البوعزيزي، لكي يُسقط الشارع أي مقدس أيقوني سياسي. أجابت السلطة بعد ذلك بمحو صور الكتّاب، وبعضها أسقطه تقلّب الطقس، وطورد فنانو الغرافيك، حتى مجموعة “زواولة” ذات الطابع الاجتماعي، واستبدلت تلك الأعمال التنويرية والنقدية بأعمال أخرى ساذجة، تؤمنها وزارة الثقافة والمندوبيات ومراكز الولاية، اكتسحت الجدران والجسور بلا أي رؤية فنية ولا قول شيء.
فقط كانت صور الشهداء، وخاصة الشهيد شكري بلعيد، ما كان يرسمه فنانو الغرافيتي، بعد اغتياله تحول إلى أيقونة مفصلة، عبر الشارب والخال وعبر الصورة الكاملة. لم يكن رسم شكري بلعيد إلا اصراراً على مواصلة الثورة من أجل الديمقراطية، وضرورة الكشف عن الذين دبّروا اغتياله واغتيال الديمقراطية في تونس.
الصورة-الرجّة، بن علي من جديد
بعيد الثورة التونسية، أقدم بعض الشباب على حركة رمزية، فأطلقوا صورة عملاقة للرئيس زين العابدين بن علي على واجهة المسرح الصيفي المسمى بـ”الكراكة” بضاحية حلق الوادي، فقام التونسيون مرعوبين ظانين أن الدكتاتور قد عاد. كانت رجّة سيميائية ذكرتهم أنه ليس أسهل من العودة إلى الديكتاتورية إن تخلوا عن الدفاع عن الديمقراطية، وعندما هجم عليها التوانسة يمزقونها وجدوا تحتها عبارة “الديكتاتورية يمكن أن تعود”.
وكانت حركة دعائية لتحفيز التونسيين على الذهاب إلى الانتخاب. لم يتعلم من تلك الحركة بعض السياسيين، ومنهم محمد نجيب الشابي، الذي قام بحملة دعائية لترشحه بصور عملاقة، فكانت هزيمته مدوية أوصلته اليوم إلى الخروج من المشهد السياسي بلا أي انجاز منذ 2011، وفقد حتى وزنه القديم ما قبل الثورة التونسية. كل ذلك أصله صورة. صورة عملاقة في الشارع.
صورة واحد بدل واحد
صورة لمواطن تونسي ينزع صورة الزعيم بورقيبة ويضع صورة بن علي، إثر انقلاب 7 نوفمبر 1987. لم يقع التعرف على الشخص الذي كان يقوم بعملية التبديل، فهو مواطن من عامة الشعب، وفي أقصى الأمر سيكون عاملاً بسيطاً في مؤسسة قيل إنها جريدة. غير أن المتأمل في هذا التفصيل أيضاً سيجعلنا نتساءل هل يعيد المواطن البسيط الديكتاتور الذي ثار عليه في صورة جديدة؟ هل يملك المواطن البسيط دائماً نفسه، أم تقوده الحاجة أيضاً لكي ينتخب أو يعلن الانتماء؟
منذ سنوات وعدد كبير من التونسيين يرفعون صور بن علي في صفحات التواصل الاجتماعي، ويظهرون في التلفزيونات يتحسرون على سنوات بن علي ويرجعون ذلك التحسر إلى غلاء المعيشة.
أطلق الفنان التونسي- الفرنسي مهدي بن شيخ، بمساعدة غاليري Itinerrance الباريسي ورعاية السلطة، تظاهرة جربة- هود Djerbahood سنة 2015، ساهم فيها 150 فناناً متخصّصاً في فنّ الجرافيتي، ينتمون إلى 30 بلداً، في جزيرة جربة، وكان العمل على جدران قرية “الرياض”.
كانت الأعمال كلها ذات طابع جمالي هادئ وغير مستفز في الغالب، إلا صورة لبوكوفسكي وأخرى للكاتب الإيرلندي الكبير صامويل بيكيت، للثنائي الإيطالي OrtieNouilles، على باب حديدي قديم يوحي بأنه باب لشيء مهمل، ويختفي وراءه عالم من القمامة. كانت الصورة ذكية ومؤلمة لكن لم تجد من يحللها ومن يضعها في موقعها الصحيح، في ظل إعلام هزيل عاد إلى الترويج للرداءة والسطحية. فصورة بيكيت مؤذنة بالعدم والخراب والانتظار التراجيدي لغودو المنقذ، والصمت المطبق الذي يتهدد الجميع وحاوية القمامة التي تنتظر الكثير من الأحلام.
صورة الرئيس أم نجمة الفريق
إثر انتخابات 2019 وفوز الرئيس قيس سعيد فوزاً ساحقاً على منافسه نبيل القروي، ظهرت من جديد صورة للرئيس لمدة ساعات في الفضاء العام. كانت هذه المرة صورة مرعبة وبشكل راديكالي، فقد أقدمت فتاة من أنصار قيس سعيد على محو نجمة من على صخرة رمزية على شاطئ بو جعفر بسوسة، ورسم صورة للرئيس المنتخب قيس سعيد. النجمة رمز لفريق كرة القدم في الساحل “النجم الرياضي الساحلي”، فانتفضت الجماهير رعباً، ليس من هذا الإنذار السياسي بالتنميط وإعادة صورة الزعيم المفدى، بل من اغتصاب حق الشعب في الاحتفاء بفريقه المفضل ورموزه التي وضعها.
ولأن جماهير كرة القدم أكثر عصبية من جماهير السياسة التي مازالت هشة، فقد وقع محو الصورة في ظرف ساعات، وعادت النجمة على الصخرة، وتعرضت الفتاة لهجمة شرسة، ما اضطرها للاعتذار في مرة أولى، وتصريحها أنها كانت حركة عفوية، ثم قامت في مرة ثانية برسم نجمة الفريق مع جماهيره على جدار كبير.
صورة الرئيس من جديد
منذ أحداث 25 كانون الثاني/جويلية 2021، بدأت تعود صورة الرئيس تدريجياً إلى الفضاء العام، من حوانيت بيع المواد الغذائية إلى الساحات العامة بداية من سوسة، كحركة رمزية تذكر بواقعة صورة الصخرة، وآخرها الصورة العملاقة التي رفعها الأنصار أمام قصر ولاية صفاقس، إثر أعفاء والي الجهة. وضع الأنصار الصورة العملاقة لقيس سعيد، وراحوا يقدمون لها التحية ويلتقطون معها الصور.
ما يعنينا في هذا التاريخ للصور المتحركة في الفضاء العام هو أنها ليست عفوية على الأطلاق، وأن الصورة أخطر من أن تقرأ كمجرد صورة. إننا نسيطر على العالم ونتحكم فيه بالصور، الصور الحقيقية والصور المزورة، لذلك نشطت خلال هذه العشرية فبركة الصور، بما في ذلك فبركة الفيديوهات، حتى في البرامج الحوارية السياسية، للتحكم في الجماهير.
مازال صوت الناقد السينمائي الهادي خليل صارخاً “أن بورقيبة سقط” بسبب إسرافه في استهلاك صورته. وغياب صورة الرئيس في الفضاء العام وعلى الأوراق المالية في تونس كان مؤشراً من المؤشرات السيميائية على إمكانية الديمقراطية، وبفقدان هذه الرمزية سنعلن نهاية الحلم بالحرية واستعادة ثقافة الاستبداد. إن الخوف ليس من الرئيس قيس سعيد بقدر ما هو خوف من شعب أصبح خبيراً في صناعة المستبد.
رصيف 22
———————————-
====================

===================
تحديث 11 آب 2021
————————–
ورطة حركة «النهضة»… وتونس/ محمد كريشان
حركة «النهضة» التونسية تواجه حاليا أسوأ وضع في تاريخها فلأول مرة يلتقي عليها القرار الرسمي والسخط الشعبي واللوم السياسي عما جرى، وفوق ذلك تصدّع داخلي غير مسبوق.
كيف وصلت تونس إلى ما هي عليه الآن بعدما فعله الرئيس قيس سعيّد ودرجة مسؤولية كل طرف قصة طويلة، لكن ما استقر في النهاية هو تحميل الحركة وزر كل شيء وهو ما عليها إلا أن تواجه ذلك لتقتلع شوكها بيدها لأن لا أحد في تونس يرغب، على ما يبدو، في مد طوق نجاة لها.
من السابق لأوانه انتشاء البعض وقولهم إن الحركة انتهت فالحركات السياسية، خاصة من هذا النوع، لا تختفي هكذا بالتمني اللهم إذا كان البعض يدفع إلى منطق الاستئصال الذي انتهجه بن علي ولم يفلح، لكنها الآن شعبيا معزولة ومحاصرة وحتى منبوذة، وهو ما لم يحدث من قبل بمثل هذا الاتساع والحدة. بدا واضحا أن إزاحة الحركة عن المشهد قد استقبل كهمّ أزيح من على صدور الناس، كما أن الحملات ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف تكاد لا تتوقف مع شماتة واضحة، لم تخل أحيانا من سخف مضحك وصل بإحدى الأسبوعيات أن تتهمها بأنها هي التي نقلت مادة نيترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت وتسببت في كارثته!!
إذا لم تسأل الحركة نفسها بكل شجاعة: لماذا وصلنا إلى هذا ؟ وكيف سنتعامل معه؟ فإنها لن تتعلّم شيئا. صحيح أن الحركة قدمت تنازلات مختلفة حتى تزيح عن نفسها صفة «الإخوانية» و»الإسلام السياسي» إلا أن ذلك لم يقابل، تونسيا قبل أي شيء آخر، سوى بكثير من الحذر أو التشكيك. الخلاصة هي أن هناك بلا جدال أزمة ثقة عميقة تفصل بين قطاعات واسعة من التونسيين و الحركة لم تزدها السنوات الماضية إلا اتساعا.
النتيجة أن التجربة الديمقراطية، بل والوطن، هو من يدفع الثمن وليس الحركة فقط، دون أن نُغفل بالتأكيد التدخلات الخارجية التي أرادت هدم النموذج التونسي المتميز
عام 2011 ومباشرة بعد سقوط حكم بن علي، صوّت لحركة «النهضة» في انتخابات المجلس التأسيسي مليون ونصف مواطن فتحصلت على 89 مقعدا من بين 217، وفي انتخابات 2014 تراجع العدد إلى 950 ألف و69 مقعدا، ثم تراجع ثانية في انتخابات 2019 إذ لم يصوّت لها سوى 560 ألف ولم تحصل سوى على 52 مقعدا في البرلمان الحالي المجمّد. ولو قدر لتونس أن تشهد انتخابات برلمانية جديدة سواء في موعدها عام 2024 أو سابقة لأوانها لرأينا هذا التراجع يزداد حدة وفق المزاج الشعبي السائد الآن.
أبدت الحركة، كما عبّر عن ذلك بيان مجلس شوراها الأخير، استعدادا لــ»التنازل» وكذلك لــ «الاعتذار» لكن ذلك، على أهميته، لم يبد كافيا ليس فقط لجموع التونسيين بل حتى لبعض أعضاء مجلس الشورى نفسه الذين أعلنوا معارضتهم لسياسات الحركة وخاصة رئيسها راشد الغنوشي. لم يغفر التونسيون للحركة سماجة الادعاء بأنها لم تحكم طوال السنوات العشر الماضية بينما هي كانت في قلب المعادلة الجديدة ومفتاحها الأول خاصة بعد أن تولى راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، ومن هنا برزت المتاعب الكبرى للحركة كما لم تبد من قبل. ارتكب الرجل غلطة عمره التي كلفت حركته وكلفت التجربة التونسية أثمانا غالية إذ جعلته في صدارة مشهد كان عليه أن يتحمّل تبعاته، الحقيقية منها والمفتعلة، الطبيعية والمدبّرة.
غلطة العمر هذه بدأت منذ أن تراجع عما قطعه هو على نفسه وهو يهمّ بالعودة إلى تونس في نهاية يناير كانون الثاني 2011 فقد تعهّد وقتها بأنه لا ينوي الترشح لأي انتخابات ولا يسعى لأي منصب وأنه يرغب في تسليم قيادة الحركة إلى جيل الشباب. ليته فعل، فلو التزم الرجل بوعده لما وصل هو وحركته إلى هذه النقطة، فضلا عن أنه كانت أمامه فرصة الخروج من الباب الكبير حين أسقط البرلمان لائحة سحب الثقة منه نهاية يوليو تموز 2020 فقد تمنى عليه بعضهم وقتها أن يفعلها بنفسه لكنه أبى ( مقالي في «القدس العربي» 4 أغسطس – أب 2020).
المراجعة الصعبة والمؤلمة لحركة «النهضة» ورئيسها كان يمكن أن تتم قبل اليوم، وفي ظروف أفضل بكثير، فالمعضلة الآن أنه إذا ترك الغنوشي الساحة فسيبدو منسحبا ومستسلما للأمر الواقع الذي فرضه الرئيس سعيّد أما إن بقي فقد تزداد الأمور سوءا في وقت يتوثب فيه الجيل الشاب في الحركة إلى تجديد دمائها.
هل الحركة تتحمّل وحدها مسؤولية ما حدث؟ بالتأكيد لا، لكنها تتحمّل القسط الأكبر منها مع تمسكها بمربع الحكم، بأي تحالفات وبأي ثمن، مع أن دور المعارضة كان يمكن أن يكون مفيدا لها أكثر وللبلاد. للآخرين أيضا نصيبهم الوفير من المسؤولية، خاصة أولئك الذين سعوا إلى إقصائها كيف ما كان بعد أن فشلوا في منازلتها عبر صناديق الاقتراع.
النتيجة أن التجربة الديمقراطية، بل والوطن، هو من يدفع الثمن وليس الحركة فقط، دون أن نُغفل بالتأكيد التدخلات الخارجية التي أرادت هدم النموذج التونسي المتميز، والتي سيأتي اليوم الذي ستنفضح فيه أكثر أمام الجميع وبالتفصيل، وتلك قصة محزنة أخرى…
كاتب وإعلامي تونسي
القدس العربي
————————
من المسؤول عن إخفاق التجربة التونسية؟/ جلبير الأشقر
عدا أقلية ضئيلة من أنصار الحكمين المصري والإماراتي، رأت الأغلبية الساحقة من مراقبي الساحة التونسية أن ما قام به قيس سعيّد إنما هو محض انقلاب، ولو أيّده قسمٌ هام من الشعب التونسي. فإن الصفة الانقلابية لتغيير ما في الحكم لا تعتمد على نسبة التأييد الشعبي له، بل تُحيل إلى لجوئه إلى القوة في خرق الدستور وفرض مشيئة الجماعة الانقلابية. وليس من قانوني محترم في تونس أو خارجها إلا ورأى أن أفعال سعيّد خارقة للدستور، وأن ادّعاءه عكس ذلك متحججاً بفقهه للقانون الدستوري، إن دلّ على شيء فعلى أن فقهه هذا من النوع الذي جعله يثني على أفعال زين العابدين بن علي أثناء دكتاتورية هذا الأخير.
أما تصريحات سعيّد الشعبوية ضد «الأحزاب» ودعواته إلى حكم الشعب، فقد سبقه عليها معمّر القذّافي وأجاد فيها بما لا يسع أحد المزايدة عليه، والكلّ يعلم أن تلك الادعاءات الخرقاء لم تكن سوى ستار شفّاف لإحدى أشرس الدكتاتوريات وأقربها إلى حكم قراقوش في المنطقة العربية. والحقيقة أن دكتاتورية سعيّد مقارنة بدكتاتورية القذّافي هي كالمسخرة مقارنة بالمأساة، لو استعرنا قول ماركس الشهير في التشبيه بين نابوليون الأول وابن شقيقه الذي أعاد تأسيس الإمبراطورية في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر.
طبعاً، شهد التاريخ كثيراً من الانقلابات التي حازت على دعم شعبي، لاسيما في منطقتنا، ومنها الانقلاب الذي نفذّه بن علي في تونس بالذات في عام 1987. وقد عرفت مصر بوجه خاص انقلابين حازا على تأييد شعبي واسع في زمنها المعاصر، ألا وهما انقلاب «الضباط الأحرار» في عام 1952 والانقلاب الذي قاده عبد الفتّاح السيسي في عام 2013. وقد ادّعى الثاني الاعتماد على الدستور بينما لم يلجأ «الضباط الأحرار» إلى مثل هذا النفاق، لكن الإنصاف يفرض علينا الاعتراف بأن السيسي، عند تنفيذ انقلابه «احترم» الدستور والمؤسسات (البرلمان والقضاء) أكثر بكثير مما فعل سعيّد!
أما ما يشترك به سعيّد والسيسي فهو أنهما نفّذا انقلاباً على مؤسسات ديمقراطية ناجمة عن ثورة شعبية حقيقية بخلاف حالة انقلاب 1952 الذي كان انقلاباً على حكم ملَكي خاضع للإنكليز وخالٍ من أي شرعية ديمقراطية. وهنا مكمن الخطورة الرئيسي في الانقلاب التونسي الجديد، وقد علّق مراقبون عديدون قائلين إن انقلاب سعيّد إنما هو المسمار الأخير في نعش «الربيع العربي» بل ذهب بعضهم إلى تكرار النغمة «الاستشراقية» المعهودة عن انعدام أهلية العرب أو المسلمين عموماً للديمقراطية.
ويذهب «التحليل» على النحو التالي: مصيبة العرب أن الدينَ طاغ عليهم إلى حدّ أن «الإسلامويين» (أو «الإسلام السياسي» وهو تعبير آخر يحبّذه الاستشراقيون) يشكلون قوة أساسية في المشهد السياسي العربي بما يخلق حلقة مفرغة بين ديمقراطية تؤدّي إلى فوز تيارات إسلامية مناقضة للديمقراطية، وتوق الناس إلى الدكتاتورية للتخلصّ من هذه التيارات. ونسجاً على هذا المنوال، نشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية يوم الإثنين مقالاً لكاتبة تونسية شرحت فيه «أن الغبطة الشعبية في ليل 25 جويلية (تموز/ يوليو) عنت أن الشعب ضاق ذرعاً بإسلام سياسي حكم طيلة عشر سنوات». يستوقفنا هذا التفسير، لا لعمقه بالطبع، بل لأنه يلخّص رأي معظم مؤيدي الانقلاب السعيّدي، وهم ينتمون إلى صنف عهدناه في المنطقة منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته الجزائر قبل ثلاثين عاماً.
بيد أن ثمة فارقاً هاماً بين الحالتين هو أن الانقلاب الجزائري جاء يسدّ الطريق الانتخابي أمام «جبهة الإنقاذ الإسلامية» بينما جاء الانقلاب السعيّدي يطيح بمؤسسات حازت «حركة النهضة» على وزن هام داخلها. ومنه زعمُ الكاتبة في مقالها المذكور أن «الإسلام السياسي» والمقصود «حركة النهضة» بوجه خاص، حكمَ تونس «طيلة عشر سنوات». هذا ويعلم أي مطّلع على مجريات الأمور في تونس منذ الثورة التي أطاحت ببن علي يوم «14 جانفي» (كانون الثاني/ يناير) 2011، أنه وصفٌ عارٍ عن الصحة: فقد فازت «النهضة» في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها الساحة التونسية في عام الانتفاضة، لكنّ موجة احتجاج شعبي عارمة ضدّها في صيف عام 2013 فرضت عليها التخلّي عن الحكم لصالح عودة النظام القديم بحلّة جديدة مثّلها حزب «نداء تونس» وقد فاز في انتخابات عام 2014 وبقي في الحكم بالرغم من تشققه حتى وفاة زعيمه الباجي قائد السبسي في عام 2019.
وإذا صحّ أن «النهضة» فازت مجدّداً بأعلى حصة في انتخابات ذاك العام، يبقى أن هذه الحصة كانت دون العشرين بالمئة بما لم يخوّلها الاستئثار بالحكم على الإطلاق. بل تراجعت حصة الحركة تراجعاً كبيراً حتى مقارنة بما حققته في انتخابات عام 2014، ناهيكم من انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» في عام 2011. ومهما يكن الأمر، فإن الأكيد أن خمساً من السنوات العشر المنصرمة منذ ثورة 2011 حكمَ خلالها مناهضو «النهضة» بمشاركة محدودة من هذه الأخيرة.
فحوى الكلام هنا أن إلقاء مسؤولية «إخفاق التجربة التونسية» على «النهضة» وحدها، أو على «الإسلام السياسي» برمّته، إنما هو أخطر من الإجحاف، إذ هو إجحاف مصحوب بتعامٍ عن مكمن الداء الأساسي وبتشخيص خاطئ لحقيقة الأزمة. والحقيقة أن سلوك «النهضة» في احترام المؤسسات الديمقراطية كان متقدماً عن سلوك «الإخوان المسلمين» في مصر على سبيل المثال. وقد يكون من نافل القول إن كاتب هذه الأسطر ليس من أنصار «النهضة» بل من ناقديها بصرامة الذين يصنّفون برنامجها بشتّى مكوّناته بالرجعي. وقد أكّد كاتب هذه الأسطر منذ سنوات عديدة (في الواقع منذ عام 2011) على أن «التجربة التونسية» آيلة إلى الفشل، شأنها في ذلك شأن كافة التجارب الثورية في منطقتنا، ما لم تخرج من دائرة النظام النيوليبرالي العالمي الذي يقوم على منح القطاع الخاص أولوية مطلقة، علماً أن الميل الطبيعي لدى معظم الرأسمال في منطقتنا ليس إلى الاستثمار في مشاريع عمرانية وتنموية، بل إلى المضاربة والجري وراء الربح السريع، ناهيكم من ضروب الفساد والإفساد.
وقد أكّد هذا الكاتب على الدوام خلال السنوات العشر المنصرمة أن لا خروج من دوّامة الأزمة التي انفجرت في «الربيع العربي» مدشّنة «سيرورة ثورية طويلة الأمد» سوى بتغيير نوعي في الطبيعة الاجتماعية للحكم، بما يتعدّى التغيير الشكلي الذي يجعل الحكم ديمقراطياً (وهو تغيير لا بدّ منه هو الآخر) تغيير نوعي يقوم على وصول قوى تمثّل مصالح الشعب العامل إلى الحكم وعلى تجييرها للسياسات الاقتصادية بما يجعل القطاع العام قاطرة تنمية رامية إلى القضاء على الفقر والبطالة واللامساواة الفاحشة.
والحال أن تونس هي البلد الذي ينعم بأبرز نموذج من مثل هذه القوى، متمثلاً بالاتحاد العام التونسي للشغل. ويُجمع المراقبون على أن الاتحاد، لو خاض المعركة الانتخابية، لتفوّق فيها على كافة القوى السياسية في البلاد. وقد سبق للاتحاد أن شارك في الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة خلال المرحلة البورقيبية، بما يجعل امتناعه عن خوضها، لمّا خلت الساحة من بدائل سياسية إثر الإطاحة ببن علي، امتناعاً شكّل سبباً رئيسياً من أسباب إخفاق التجربة. وتشارك الاتحاد في هذه المسؤولية قوى اليسار التونسي الطاغية داخل صفوفه والتي أيدّت ذريعة فصل النقابي عن السياسي التي لا مبرّر لها، لا من حيث المبدأ ولا من حيث الواقع التونسي. هذا ولا طريق إلى خروج تونس من أزمتها سوى بخروجها من دائرة السياسات النيوليبرالية وإرشادات صندوق النقد الدولي.
هنا بيت القصيد ومكمن العلّة الأساسي، وليس في حركة «النهضة» أو سواها. ومن يعتقد أن قيس سعيّد سوف يُخرج تونس من الأزمة ويؤمّن التشغيل لشبيبتها ويضع البلاد على سكة التنمية المستدامة والديمقراطية الناجعة، إنما لا يختلف في توهّمه عمّن ظنّ مثل هذا الظنّ ببن علي والسيسي عندما أجرى كلٌ منهما انقلابه.
كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
—————————-
الأزمة التونسية في سجال الإسلاميين .. بين المرونة والمواجهة/ خيري عمر
تكشف الأزمة السياسية في تونس، بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد، عن مدى تطور تجارب الحراك السياسي في المنطقة العربية، فقد ظلت تونس تقدّم الحالة الفضلى للتكيف مع تعقيدات المراحل الانتقالية، غير أن التداعيات الراهنة تثير الجدل بشأن قدرة الحركات الإسلامية على تقديم قراءات للمرحلة الماضية وإعادة النظر في مشروعها السياسي، فمن خلال تناول التفاعلات الجماعية والفردية، يمكن الوقوف على الملامح العامة لإدراك مكونات الإسلام السياسي للأحداث والظواهر السياسية.
منذ البداية، ظهرت قرارات 25 يوليو/ تموز 2021، كمواجهة شاملة مع كل الأطراف السياسية، ما أوجد مساحة واسعة من المضارّين، ولذلك لقيت معارضةً مؤقتةً من كتل برلمانية ما لبثت أن تغيرت سريعاً، وصارت أقرب إلى تجنب الصدام مع الرئيس، والبحث عن حل سياسي. وبغض النظر عن الخلاف في تفسير المادة 80 من الدستور التونسي، يهدف قرار تجميد البرلمان إلى تقييد حركة النهضة، فهو المنصّة الوحيدة للنظر منها إلى السلطة، ويمثل رفع الحصانة ضغطاً إضافياً على البرلمان يتضمن توجهاً لتسهيل التحقيقات القضائية، حيث تبدو خطّة تعطيل البرلمان ماضية نحو أهدافها، بسبب تساند كتل مهمة وراء قرار الرئيس، بجانب مرونة تقدير حالة الطوارئ وإطلاق يد السلطة في التصرّف في تحديد إجراءاتها، وتراجع ضمانات توازن السلطات.
وقد سارت انطباعاتٌ بأن نجاح قرارات قيس سعيّد يتوقف على اعتقال رموز الحكومة والشخصيات المهمة في مجلس نواب الشعب، ويذهب إلى أن تأخّر هذه الخطوات سوف يعمل على تغيير المواقف الدولية ويجعلها أقرب إلى الحلول التفاوضية، غير أن مضي الرئيس في خطوات ترتيب الشكل السياسي الانتقالي يكشف عن ملامح تؤدّي إلى تجاوز النظام البرلماني، وعلى الرغم من صعوبات تغيير النظام السياسي، تُراكم الإجراءات اليومية واقعاً مختلفاً، بدت مشاهداته في دخول القضاء العسكري طرفاً في العملية السياسية.
لم تستمر حركة النهضة في وصف ما حدث بالانقلاب، واتجهت إلى بناء موقف مرن (26 يوليو/ تموز 2021) يجمع ما بين التشاور واحترام الدستور، بهدف البحث عن الحلول الممكنة للخروج من الأزمة، وتفكيك جبهة الاستهداف الداخلي والخارجي. ويبدو أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، يحاول تجنّب مسار الإخوان المسلمين المصريين، فقد أكد غير مرة على إمكانية تقديم التنازلات الكافية للخروج من الأزمة والحفاظ على الدستور والديمقراطية. وعلى الرغم من نقص الأدوات السياسية وانقطاع التواصل بين مكونات الدولة، توفر هذه التوجهات أرضية ملائمة لمنع وصول التداعيات إلى نقطة حرجة، يكون من بينها الحفاظ على المؤسسات وسد ذرائع الراديكالية. لعل الوجه الآخر يتمثل في أنه، على الرغم من تعطيل السلطة التشريعية، تباعد خطاب “النهضة” مع تعميق النزاع والالتزام بوقف التظاهر أو الاعتصام أمام المؤسسات، وذلك على خلاف تجربة الإخوان في مصر التي سارت على مصارعة الحكومة ثماني سنوات.
وعلى مستوى الحركات الإسلامية، ثارت اتجاهاتٌ متباينة، فقد ظهرت توجهات ترجع الأزمة إلى نقص المؤسسات الدستورية ورفض الرئيس اعتماد القوانين الصادرة من البرلمان، وهي عوامل ترتبط بعدم قدرة “النهضة” على فهم سياقات التناقض بين مكونات السلطة. ولذلك تخلص إلى تبنّي رؤى تفاوضية لحل الأزمة، تقوم على عدم اللجوء إلى العنف، وقد استرشدت هذه الآراء بفشل تجارب العنف ضد الدولة في غياب تصوّر عن السلطة والإصلاح السياسي، وتعتبر أن ظروف خروج الجماهير في 2011 لم تعد متوفرة، بسبب عدم قدرة النخبة على استثمارها في عملية تحوّل سياسي، وظهور العيوب الواضحة للنخبة السياسة وتدهور البنى التنظيمية للمعارضة وإخفاقها في التعبير عن مطالب الجماهير، تُعبّر هذه التوجهات عن محاولة للاستفادة من تقييم أحداث السنوات الماضية، والتي شهدت خسارة صافية للمعارضة.
وعلى جانب آخر، بدت اتجاهاتٌ أكثر راديكالية رأت ضرورة المواجهة والمقاومة أو المفاصلة مع النظم الحاكمة. وبجانب السخرية من الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعت إلى اضطلاع البرلمان بعزله وحصار قصر قرطاج، وتكوين جبهة إقليمية للتدخل ضد الإمارات ومصر، باعتبارهما داعمين لتكرار تجربة “30 يونيو” في عام 2013 في مصر. وقد حاولت هذه الآراء تقديم مقاربةٍ تقوم على أهلية الحركة المصرية وكفاءتها، تقوم على افتراض أن بقاء “الإخوان المسلمين” في الحكم يمثل فرصة للتغيير والإصلاح، وأن خطأ الثورات يتمثل في عدم اجتثاث الفساد، لكنها لم تتمكّن من هذا بسبب إزاحتها بعد عام واحد، ومن ثم، فإن خطأ حركة النهضة يتمثل في عدم استثمار عشر سنوات في بناء النظام الخاص بها، وتركها الفرصة للثورة المضادّة لتشويه صورتها أمام الجماهير والاستمرار في مواقعها في الدولة.
وبينما مالت الأحزاب المغاربية إلى تسوية الأزمة بالحوار، وضع إخوان سورية، (27 يوليو/ تموز 2021) قرارات قيس سعيّد ضمن مؤامرة ومعركة صفرية تغطي العالم الإسلامي، ولا تقتصر على العراق وسورية ولبنان واليمن ومصر وليبيا، تماثل في أهدافها حروب الفرنجة، ولذلك خلصت إلى أن المواجهة تمثل الحل الملائم للدفاع عن الثورة التونسية. يكشف هذا الكلام عن جوانب من السياسات الغربية، غير أن خيار المواجهة غير رشيد لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها، ترهل النخب الحركية وفسادها وفشلها الدائم في السلم والعنف. ويمكن فهم هذه التطلعات نوعاً من التذرّع للاستمرار في صدارة المشهد. وبشكل يتماثل مع وضع قيادات “الإخوان المسلمين” في كل البلدان للبقاء في المناصب دورات عدة لإدارة معارك لانهائية من دون انتصار.
يميل الموقف العام لقطاعٍ من حركة الإخوان المسلمين إلى الحلول الصراعية، وباعتبار وصفهم قرارات تونس بالانقلاب، فقد سار التناول نحو استدعاء فكرة المقاومة والاعتصام حلاً نهائياً للتخلص من الثورة المضادّة، وقد بدت مثل هذه التوجهات في اليوم الأول لدى حركة النهضة، لكنها شكّلت قناعة مستمرة لدى بعض الإخوان المصريين، ترجع إلى عدم القدرة على تُلمس اختلاف السياقات بين مصر وتونس، واستمرار الانخراط السياسي من دون تقييمٍ يساعد في الإقلاع عن الاستعلاء على التجارب الأخرى واتهامها بالفشل.
تهيمن قناعات المؤامرة وفقدان القدرة على التفسير على قطاعٍ من الإسلاميين المصريين بطريقة تدفعه إلى تبنّي الحلول الصدامية. وتبدو مؤشّرات عدم الثقة في الحلول التفاوضية واضحة في تناول أحداث تونس، عندما ظهرت إشاراتٌ متكرّرة لنصح حركة النهضة بمواجهة الانقلاب، واعتبار الديمقراطية مناهضة للإسلام، وليست حلاً للمشكلات السياسية، وقد صنفت هذه النوعية من الآراء موقف الغرب بأنه معادٍ لتوجهات حركة الإخوان المسلمين بسبب توجهاتها الدينية الإصلاحية، وذلك باعتبارها الحركة السنية الممتدة في بلدانٍ عديدة.
غير أنه من خلال مؤشرات المشاركة السياسية والمحتوى الفكري، يتضح أنها وقعت أسيرة التجربة القومية/ المحلية، ولم تتمكّن من تقديم نموذج ناضج، سواء في وضعها حزبا حاكما أو مشاركا في البرلمان، وظلت مساهمتها ضمن معارضة متراجعة سنوات طويلة. ومن الناحية التنظيمية، لم تعد تمثل تياراً قادراً على التغيير أو طرح مبادراتٍ للخروج من مشكلاتها مع غالبية الحكومات. ويخلص بعض الآراء إلى أن المشكلات الهيكلية في جماعة الإخوان المسلمين تمثل جذر أزماتها في البلدان العربية، ويقتضي تاريخها الطويل من الفشل طي صفحتها، فلم تقدّم نموذجاً سياساً ناجحاً، على الرغم من وصولها إلى السلطة في السودان ومصر والعراق، كما أن مشاركتها في عدة تجارب أخرى ظلت متذبذبة ومتواضعة. في الحالة المصرية، لا يتجاوز ما قدّمته شلة من العلاقات القرابية، اتسمت بانخفاض الكفاءة وعدم الإلمام بمقتضيات الدولة.
على مدى السنوات الماضيةً، بدت فروع حركة الإخوان المسلمين في تراجع سريع، فمن جهةٍ لم تنجح في تقديم نفسها بديلاً للنظم السياسية، أو تجنّبت برامج التهميش والعزل السياسي، بحيث صارت مرشّحة للأفول والعزلة الاجتماعية في بعض البلدان، وغير قادرة على تعويض خسارتها من الرأسمال الاجتماعي. ومن جهة أخرى، افتقرت لوجود استراتيجية لبناء تحالفٍ على المستوى الإقليمي أو الدولي، وصارت عبئا على داعميها بعد 2013، بعد فشل حركات الإخوان المسلمين في إثبات جدارتها بصدد أزمتها مع الحكومة المصرية. وهنا، بدت محاولة توجيه خطاب لتهنئة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالغة السذاجة، سواء بافتقادها سياقا ملائما أو السعي المفرط للاعتماد على قوة أجنبية. وفي سياق مماثل، وعلى مدى سنوات “الثورة السورية” تحولت المعارضة إلى مجموعات هشّة، وظهر أن التعويل على دور الإخوان المسلمين صاحبته تقديراتٌ غير واقعية.
وكحالة ممثلة، تقدّم الحالة المصرية وضعاً جامداً لأزمات الإخوان المسلمين، فمن جانب، ينصرف الاهتمام الأساسي نحو الصراعات التنظيمية، وانحسار الاهتمام بحل مشكلات المعتقلين. ومن جانب آخر، يمارس قسم كبير منها المعارضة، متبنّياً موقفاً صارماً للثورة ومكافحة الدولة والخروج عليها. ساهمت هيمنة هذه التصوّرات في انحسار الأجندة السياسية لتقتصر على شؤونها الداخلية الضيقة على مقاس المصالح الشخصية. وتظهر حركة الإخوان شبكات لا تملك مقومات التغيير في بلدانها. وخلال خبرة السنوات السابقة، لم تتمكّن الحركة المصرية في الخارج من تقديم نموذج للتصحيح والتطوير. ويمكن ملاحظة أنه مع اتساع نطاق الحرية ظهرت الجماعة مشكلة اجتماعية وسياسية أكثر منها حلاً إصلاحياً.
وعلى الرغم من اختلاف أداء “النهضة” مقارنة بمثيلاتها، فقد ساهمت قيود الصراع السياسي والتنافس الأيديولوجي في الوصول إلى نظام حكم لا يناسب التغيير المرغوب. وظل يشكل واحداً من ملامح السلطات المتوازية، وهي، على أية حال، قدّمت خبرة في التفاوض، على خلاف انحياز الأحزاب الإسلامية الأخرى للبقاء في مربع الأزمة وتجديد الصراع. وتبدو الخصائص المشتركة في غياب مشروعات التحول السياسي والاقتصادي، ما يجعلها مشكلة دائمة.
العربي الجديد،
———————–
من يجرؤ على الكلام في تونس اليوم؟/ محمد صالح المسفر
اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نفسه المرجعية الرئيسية لتفسير دستور بلاده، وخصوصا المادة 80. وقد كُتب الكثير شرحا وتحليلا لهذه المادة، وعن أحداث تونس بعد واقعة “25 يوليو”، ثورة/ انقلاب الرئيس سعيّد على النظام السياسي الذي يرأسه، الأمر الذي أدّى إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان واختصاصاته 30 يوما قد تمدّد، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب، وتسلم مقاليد السلطة التنفيذية، وعهد إلى الجيش بحراسة المقار الحكومية والبرلمان إلى جانب قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن العام .. ما يجري في تونس اليوم مخيف على مستقبل استقلال البلاد وسيادتها، ويفتح المجال واسعاً لتدخلات خارجية، وكان الكاتب قد نبّه إلى مخاطر ما ستؤول إليه أحوال تونس.
(2)
كان لدي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، إحساس بأنّ هناك أمرا يبرم للنيْل من تونس وثورتها، فكتبت (في 23/10 في صحيفة الشرق القطرية)، ما جاء فيه “من أجل تونس المستقبل، مطلوب من كلّ القوى السياسية أن يقدّموا مصلحة تونس ونجاح التجربة الديمقراطية الحقة فوق كل اعتبار. وعلى ذلك، لا بد من تقديم تنازلات من كل الأطراف لتحقيق المصلحة العامة من أجل الانطلاق بتونس العزيزة في معراج البناء والإنتاج والسلام الأهلي”.
(3)
تعاظم، في 5 أغسطس/ آب 2020، خوفي على مستقبل تونس، وكتبت في “العربي الجديد” مقالاً عنوانه “ماذا يجري في تونس؟” ومما جاء في ذلك المقال: تتسارع الأحداث في تونس الخضراء، أم الربيع العربي، وفي كلّ يوم يمرّ تزداد تعقيدا”. وناشدت أهل القلم بالقول: “علينا، معشر القلم الحر، أن نعين الرئيس سعيّد بأن نسدي له النصح والمشورة، ولو من خلف الحدود الجغرافية لتونس”. وقلت في نصيحتي: “فخامة الرئيس:. يدي على قلبي على ما يجري في تونس اليوم. انطلاقا من دعوتكم إلى تحقيق “الديمقراطية الشعبية”.
وهذا النوع من الديمقراطيات لم يعد صالحا في زماننا الذي اختلطت فيه الموازين. حاوله معمر القذافي ، ثم تراجع عنه بعد حين. من الملاحظ، سيادة الرئيس، أنكم تسيرون بخطواتٍ سريعة نحو إرباك العملية السياسية في تونس، بتجاوزكم الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية (البرلمان) عند اختياركم وزير داخليتكم، ليشكل الحكومة الجديدة، هشام المشيشي.
(4)
أعرف، كما يعرف الخلق، أن هناك أحزابا تعيق السير نحو ديمقراطية حقيقية في تونس وغيرها. والكل يعرف، ومقامكم الرفيع يعرف، أن في تونس “أحزاباً” بعض المتصدّرين فيها بلا تاريخ سياسي، وبدون مشروع وطني تونسي، إلا العودة بالبلاد والعباد إلى عصر الطغيان والاستبداد والفساد، مرضاة لقادة الثورة المضادّة الذين يعيثون في الوطن العربي الفساد والدمار وخراب الذمم. هذه الأحزاب نعرفها من بعيد، وتعرفونها عن قرب. إنها تخدم مصالح وأطماع قوى من خارج الحدود التونسية. ولدت من رحم الثورة المضادة لثورة الياسمين الشريفة الطاهرة. هناك أحزاب في تونس، عريقة، جذورها عميقة في تاريخ تونس الوطني، يمكن المراهنة عليها.
(5)
في السابع من الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، كتبت في “العربي الجديد” مقالا بعنوان “الجزائر مستهدفة إسرائيليا…” وقلت: هذه تونس، أم الربيع العربي، تتناهشها أيادي الشر من الداخل والخارج، للنيْل منها ومن شعبها صاحب التاريخ العريق في مقاومة الاستعمار والفاسدين والطغاه والظالمين ولكنها ستكون الجبل الشامخ الذي تتحطم على صخوره كل المؤامرات ولو أنفق المتأمرون كل عائدات النفط العربي، ..”. ذلك كان استقرائي لما يجري في تونس، فما هو حالها اليوم؟
(6)
أصبح حال تونس اليوم لا يسر صديقا، ولا يخدم البلاد. استخدم الرئيس سلطة المادة 80 من الدستور وقرأها كمن يقرأ الآية الكريمة “ولا تقربوا الصلاة…” من دون أن يكملها، فتكون قراءة مبتورة، توحي بمنع الصلاة عند العامّة. الخلاف الذي أدّى إلى تصاعد الأزمة كما يعتقد أهل تونس هو التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته، وخروج عدد من الوزراء بمن فيهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين، صديق الرئيس سعيّد ومنسق حملته الانتخابية، ما جعل الرئيس لا يقبل بالتعديل الوزاري، على الرغم من منح البرلمان الثقة به. وعلى أثر ذلك، لم يسمح الرئيس بأداء الوزراء اليمين القانونية أمامه، وبذلك يكون مخالفا للدستور، كما قال هو، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، لإذاعة “موزاييك إف إم” إنّ تعطيل الرئيس الباجي السبسي أداء اليمين يعتبر خرقا للدستور.
سيادة الرئيس قيس سعيّد: لا تغرّنك الوعود من بعض الدول التي أشرت إليها أنها باركت ما فعلت، وأنها ستقدم لك الدعم الاقتصادي لانتشال تونس من ربقة الحاجة المالية، وللقضاء على البطالة أو مواجهة جائحة كورونا. إنها وعود لا تُسقط المطر، واسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والحكومة السودانية عن وعود بعضهم التي لم يتم الوفاء بها إلا بشروط مجحفة، لا يقبل بها الشعب التونسي، وما برحت مصر غارقة في ديونها.
آخر القول: العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل، وهناك فرصة للعودة إلى حوار وطني ينقذ تونس من الوقوع في الهاوية.
العربي الجديد
————————
تونس. حركة النهضة، حزب محافظ بدون هوية/ سارة قريرة
منذ الإعلان الذي قام به الرئيس قيس سعيد في تأويل شخصي للفصل 80 من الدستور احتكر من خلاله جميع السلط، تتالت ردود فعل أعضاء حركة النهضة لتترجم أكثر من أي وقت مضى عن الانقسامات العميقة في صفوف الحزب. وكان لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي منعه الجيش بأمر رئاسي من دخول مجلس الشعب “المجمَّد”، حضور مهم في الصحافة الدولية. ففي مقال رأي له في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حذّر الغنوشي من عودة إلى الدكتاتورية
1
، بينما ناشد في صحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” إيطاليا بالتدخل، محرّكا فزاعة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
2
. في الأثناء، انتقد قياديون حاليون أو مستقيلون في وسائل الإعلام المحلية تعنّت الحزب الذي قاد البلاد إلى هذا المأزق، وطالبوا إدارته بتغيير مواقفها.
عشية الأربعاء 4 أغسطس/آب، انعقد مجلس شورى حركة النهضة لتدارس الوضع وأخذ قرارات بشأن الفترة المقبلة، وكانت منشورات بعض القياديين على فيسبوك بمثابة التعليق المباشر على هذا الاجتماع. ثلاث نائبات انسحبن، من بينهن يمينة الزغلامي التي استنكرت “سياسة الهروب إلى الأمام”، بينما تحدث الوزير السابق سمير ديلو عن “حالة إنكار”. من جهته، دوّن عبد اللطيف المكي عضو المكتب التنفيذي ووزير الصحة في 2020 قائلا: “من لم يقنعه التاريخ على امتداده وبوقائعه الصلبة الصارخة فلن أستطيع إقناعه أنا العبد الضعيف المتواضع ولا كذلك غيري”.
لم يصدر بيان المجلس إلا عشية يوم غد بعد نشر بعض التصريحات المتضاربة. ندد الحزب بالـ“انقلاب على الدستور وشلّ مؤسسات الدولة”، وتفهم “الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة”، لكنه طالب بأولوية عودة الأمور إلى نصابها و“ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته”.
ثمن التنازلات
هذه هي المرة الأولى التي لا تمتص فيها الأزمة الوطنية الخلافات الموجودة داخل الحركة. فحتى الآن، كان وجود الحزب هو المصلحة العليا التي تدفع بعناصرها إلى توحيد الصفوف أمام الخطر الخارجي.
لفهم بعض الخيارات التي قامت بها النهضة منذ ،2011 يجب الأخذ بعين الاعتبار القمع الشديد الذي تعرضت إليه تحت نظام بن علي، الذي ترأس البلاد بعد انقلاب السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987. فبعد فترة انفتاح قصيرة، انقلب النظام بداية التسعينيات على الحركة الإسلامية -كما انقلب على بقية أحزاب المعارضة-، وتعددت الاعتقالات والمحاكمات من بينها أحكام مؤبدة، ناهيك عن أعمال التعذيب والاغتصاب في السجون. وقد رأى عناصر الحركة في الخطاب الاستئصالي لجزء من المجتمع الذي يأبى أن يكون للإسلاميين مكانة سياسية شرعية صدى لهذه الفترة. كما عززت نهاية التجربة المصرية بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي هذه الصدمة.
هذا ما يفسر جزئيا توجه النهضة. يقول الكاتب حاتم نفطي: “رغم فوزها بانتخابات المجلس التأسيسي [في أكتوبر/تشرين الأول 2011] وتواجدها الراسخ على كامل تراب البلاد، كانت حركة النهضة تعي جيدا تحفظ النخب السياسية والإعلامية والمالية تجاهها”، ويذكر بأنه “من الصعب جدا أن تحكم بلادا ضد نخبها”.
لذا، ورغم أن النهضة تدين للثورة بعودتها الشرعية للحقل السياسي، فهي لم تنتم تماما إلى المعسكر الثوري، لكنها كانت في الوقت نفسه تستعمل هذه الحجة لضرب منافسيها السياسيين، واصفة إياهم بـ“أزلام النظام السابق” وعملاء الثورة المضادة. من هنا، أصبحت أولوية الحزب البقاء في منظومة الحكم، وهي أولوية تمر بالتغزل بقياديي التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي الذي تم حلّه في 2011. تمت تسمية مسؤولين من هذا الحزب على رأس إدارات ومؤسسات عمومية. بل وفي 2020، انضم إلى مكتب رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي كل من محمد الغرياني -الأمين العام الأخير للتجمع الدستوري الديمقراطي- وماهر مذيوب الذي كان يكتب تقارير في المعارضين زمن الديكتاتورية وقد بات نائبا عن الحركة. أما البقية الذين سمحت لهم النهضة بالعودة إلى الحياة السياسية بتنازلها عن قانون “تحصين الثورة” (2014)، فهم حجة ثمينة تسمح بتعبئة القواعد الانتخابية للحركة الإسلامية. حتما، فوجود تهديد وجودي على الحركة مثل الحزب الدستوري الحر لعبير موسي (وريثة بن علي) يمكّن من توحيد الصفوف. ونجد المنطق نفسه في الجهة المقابلة، حيث تكون العداوة البدائية للإسلاميين أكثر تجميعا من أي برنامج سياسي.
من حزب إسلاموي إلى حزب “إسلامي محافظ”
اللعب على حبلي الثورة والثورة المضادة بلغ ذروته خلال الحملتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية لسنة 2014. عادت النهضة حينئذ إلى خطاب الخطر الوجودي الذي يحدّق بها.. قبل أن تتحالف مع حزب “نداء تونس” ورئيسه الباجي قايد السبسي الفائز بالانتخابات، والذي كان قد جمع حوله أعداء الإسلاميين من أطياف سياسية مختلفة.
يظهر كذلك هذا الشرخ في الحدود الفاصلة بين المعسكرين من خلال المواجهة بين حركة النهضة وقيس سعيد، ذلك الرئيس المحافظ الذي لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية في شكلها الحالي، لكنه وصل إلى الحكم بفضل أنصار الثورة الذين انتخبوه ضد المرشح نبيل القروي الذي يمثل النظام السابق وفساده. بيد أن النهضة اختارت بعد أشهر أن تتحالف مع “قلب تونس” -حزب نبيل القروي- لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ في سبتمبر/أيلول 2020 وتأليف أغلبية برلمانية.
وفق القراءة الإقليمية لميزان القوى، تنتمي حركة الإخوان المسلمين التي تدعمها قطر إلى معسكر الثورة، بينما تساند الإمارات العربية المتحدة -التي ساهمت في تمويل حزب “نداء تونس”- الثورة المضادة. لكن هذه القراءة لا تلخص ما يحدث في تونس، على عكس ما يعتقده عدد من المعلّقين، حتى وإن لم يزل منطق المواجهة بين بلدان الخليج قائما، كما يظهر ذلك من خلال المواقف السعودية والإمارتية والمصرية المساندة لقيس سعيد.
من جهة أخرى -وعلى الخصوص-، باتت هوية الحزب -كحركة إسلامية- ضعيفة. فبمناسبة مؤتمرها لسنة 2016، قرر ت النهضة الفصل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي. وبانخراطها هكذا تماما في الشرعية السياسية، تنازلت الحركة عن ميزتها ونقطة قوتها الأولى التي جعلت منها العدو اللدود لنظام بن علي، والتي اهترأت بممارستها للحكم. هكذا إذن أصبحت النهضة حزبا “إسلاميا محافظا” بعد أن كانت حزبا إسلامويا، ودخلت اللعبة السياسية تماما لكنها فقدت جزءا من هويتها.
الإسلام ليس الحلّ
3
]]
هذا التنازل رفع الحجاب عن عيب كبير تعاني منه الحركة كغيرها من أحزاب الساحة السياسية التونسية، ألا وهو انعدام برنامج اقتصادي واجتماعي. يقول كريم عزّوز، وهو عضو في المكتب الفرنسي للحركة: “لقد أنشئت النهضة لثلاثة أسباب. الأول هو المواجهة بين الدولة الوطنية والثقافة الإسلامية، والثاني هو مسألة الحريات، والثالث هو الفوارق الاجتماعية. لم يعد للسببين الأولين معنى اليوم، ولم تستطع الحركة أن تقدم اقتراحات في النقطة الثالثة”.
يمكن تفسير هذا الإخفاق -جزئيا- من خلال الفوارق السوسيولوجية التي تسعى النهضة إلى تجاوزها دون جدوى منذ عشر سنوات. فمن جهة، تنتمي قواعد الحزب وأغلب ناخبيه إلى الهوامش، لا سيما في المناطق الداخلية، ما يدفع بعدد من معارضيها إلى تبني خطاب يمتزج فيه عداء الإسلاموية بازدراء الفقراء والمهمشين. ومن جهة أخرى، فهي تمثل جزءا من الطبقة البرجوازية المحافظة، وبذلك فهي تجمع بين ضحايا الحداثة الاقتصادية وبين أصحاب خطاب الهوية. لكن البلاد على شفا حفرة من الإفلاس، والنهضة لم تقترح أي برنامج اقتصادي، بل إنها لم تنتقد المنعرج الليبيرالي الذي اتخذته الدولة منذ الثمانينيات ولا انتقدت “الإصلاحات” التي يفرضها الممولون، علاوة على أنها لا تقترح حلا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.
إلى جانب ذلك، فقد شاركت أو ساندت النهضة جميع الحكومات المتعاقبة التي قمعت -أحيانا بالرصاص الحي- التحركات الاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ 2011. أخيرا وليس آخرا، يجب الإشارة إلى أن التونسيين لا يزالون يخشون عودة الدولة البوليسية، وأن النهضة ساندت حتى آخر رمق هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الذي عزله قيس سعيد، والذي عاد معه شبح القمع البوليسي. ففي يناير/كانون الثاني 2021، أي في الذكرى العاشرة للثورة، سجلت تونس 968 اعتقالا حسب المصادر الرسمية (وضعف هذا العدد حسب الجمعيات) خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد أو على هامشها.
حزب استنفد طاقته
ليسوا بالنادرين أولئك الذين في صفوف النهضة يرون في الأزمة الحالية فرصة لحزبهم. فالخطر على الديمقراطية الذي يخشاه منتقدو الرئيس قيس سعيد -وهم على حق في ذلك- يحدق أيضا بالحركة، بعد أن أزاح الشيخ راشد الغنوشي جميع منافسيه وبات يحلم برئاسة مدى الحياة، على غرار القادة العرب السلطويين. عارضه في ذلك مائة عضو بالحركة في رسالة مفتوحة نشرت في شهر سبتمبر/أيلول 2020، وقد كانت مؤشرا للانقسامات التي تهدد هذا الحزب الذي لم يعد في ريعان شبابه. مؤخرا، طالب قياديون تاريخيون مثل محمد بن سالم أمام الملأ راشد الغنوشي بالاستقالة من الحياة السياسية. وكان قبله عبد الحميد الجلاصي الذي استقال في مارس/آذار 2020 بعد 40 سنة من النضال داخل الحزب، قد صرّح قائلا إن “النهضة التي دخلت إلى الدولة وأصبحت جزءا من المنظومة […] لم تعد وفية لقيمها”.
إذ يُضاف إلى الإخفاق السياسي فضائح الفساد العديدة التي تخللت حياة الحركة السياسية خلال العشرية الأخيرة، حتى أصبح يُشار إليها -مع غيرها من عناصر المشهد السياسي- بلقب “الطرابلسية الجدد”
4
. آخر هذه الفضائح هو تقرير دائرة المحاسبات (نوفمبر/تشرين الثاني 2020) الذي بين أن النهضة تلقت تمويلات خارجية وغير قانونية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2019، وكان الحزب قد استعان بـ“لوبيات” أمريكية. ولا ننسى الملف القضائي، حيث تم في 13 يوليو/تموز إيقاف وكيل الجمهورية البشير العكرمي -القريب من النهضة- عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بتهمة “شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب”. ما يجعل مراقبين يذكّرون بتاريخ أعمال العنف للحركة عندما لم يكن لها وجود شرعي.
هذا الجمود الذي يتحمل حزب حركة النهضة جزءا كبيرا من مسؤوليته يفسّر فرح الجماهير التي خرجت مساء يوم 25 يوليو/تموز احتفالا بقرارات قيس سعيد، وهو فرح يتقاسمه جزء من الذين يلومون على النهضة تحريفها لمسار الثورة مع من يشتاقون إلى النظام السابق، نكاية في عدوهم اللدود. يمكن أن نتفهم إذن إصرار عدد من أنصار الحركة على أن يراجع الحزب نفسه ويتجدد قبل وفات الأوان. يبقى السؤال هو: إلى أي مدى ستذهب هذه المراجعة وماهي الرؤية الإسلاموية الجديدة والاقتصادية التي سيقترحها هؤلاء؟
سارة قريرة
صحفية، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي، مسؤولة عن الصفحات العربية لموقع أوريان 21.
———————————-
تونس. تغيّر حتمي لكنه محفوف بالمخاطر/ تيري بريزيون
ترجم هذا المقال من الفرنسية حميد العربي.
هل هو “انقلاب”؟ أم “انقلاب شعبي”؟ أم “انقلاب دستوري”؟ أم هو تطبيق مبرر للدستور؟ يحتدم الجدل منذ 25 يوليو/تموز 2021. بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة شهد مشاركة واسعة في جميع أنحاء البلاد، والتي غالبًا ما كانت موجهة ضد حزب النهضة الإسلامي المحافظ، أطلق قيس سعيّد “الصاروخ” الذي كان يهدد به الطبقة السياسية منذ عدة أشهر. إذ قام بتفعيل المادة 80 من الدستور التي تسمح باتخاذ كافة “التدابير” لمواجهة “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد”. وبالتالي، تولى على الفور وبشكل انفرادي قيادة السلطة التنفيذية بعد أن أقال رئيس الحكومة، وأعلن أنه سيختار رئيس الحكومة القادم بنفسه، كما جمد نشاط البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن النواب. باختصار، جمع قيس سعيد كل السلطات بين يديه.
بالنسبة لحركة النهضة، فإن الأمر واضح: إنه “انقلاب غير قانوني وغير دستوري” وقد “عمل قيس سعيد مع قوى غير ديمقراطية للإطاحة بالحقوق الدستورية للمنتخبين واستبدالهم بأعضاء من عصبته”. غير أن الرئيس يحظى بتأييد شعبي، إذ تظهر استطلاعات الرأي بأن 87٪ من التونسيين يؤيدون انقلابه ويرون فيه الرجل المنقذ للبلاد. يصعب بين هذين الموقفين، عرض تعقيدات الوضع، ولكن لنحاول.
مسألة سياسية أكثر منها قانونية
يرى خبراء القانون -ولا تنقصهم الحجة- بأن قيس سعيد تجاوز الصلاحيات التي يمنحها إياه الدستور في نقطتين على الأقل. أولاً، كان من غير الممكن مشاورة المحكمة الدستورية مسبقا لأنها لم تتشكل بعد. حتى وإن كان هذا الإلزام شكليا، فهو يعد ثغرة تجعل الإجراء المنصوص عليه في المادة 80 غير قابل للتطبيق. ثانيا، يتعارض تجميد مجلس النواب مع مادة لا لبس فيها تنص على أنه يبقى في حالة انعقاد دائم خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، فإن الضمان الذي تمنحه الإمكانية لرئيس مجلس الشعب أو ثلثي النواب باللجوء إلى المحكمة الدستورية بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما قصد التحقق من “استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه” مستحيلا في غياب وجود هذه الهيئة. لذا يبقى قيس سعيّد الوحيد الذي يقرر بشأن الوضع الذي يسمح بالعودة إلى القانون العادي. فقد تجاوز رئيس الدولة الذي يولي تقديرا كبيرا لخبرته في القانون الدستوري، حواجز الأمان الدستورية بوضوح.
إن الجدل حول “الانقلاب” من عدمه هو من النوع الذي لا يُفصل فيه أبدا. فحتى الأنظمة الليبرالية التي يحل فيها القانون محل القوة تدرج في ترتيباتها الدستورية ذلك الجانب الصغير من الغموض الذي يستطيع بفضله الحاكم التحرر من كل القيود، عندما يتعرض النظام السياسي للتهديد. هي ترتيبات مؤطرة طبعا، ولكن حسب تعبير الفيلسوف المثير للجدل كارل شميت، منظر حالة الاستثناء، “ليس للضرورة قانونا”. بعبارة أخرى، تزول التقييمات القانونية أمام ضرورات بقاء الدولة. قد يتيح هذا الجدل بلا شك فرصة لمساهمات أكاديمية مثمرة لخبراء القانون. غير أن السؤال الحقيقي سياسي، ويُطرح على مرحلتين: أولا، ما هو الخطر الداهم الذي يستدعي اللجوء إلى حالة الاستثناء وإلى أي مدى يمكن أن يُقدم هذا اللجوء حلا لذلك؟ ثم في أي اتجاه ستتطور ممارسة السلطة؟
إجماع تبادلي
تراكم عشية 25 يوليو/تموز في تونس كم كبير من المخاطر إلى درجة أن احتمال تحولها إلى دولة فاشلة صار يلوح في الأفق. يقال الكثير عن دور قيس سعيّد في انسداد العمل الحكومي خلال الأشهر الأخيرة ورفضه التعامل مع الأغلبية البرلمانية والتصديق على التغيير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي عينه هو نفسه في يناير/كانون الثاني 2021. غير أن للأزمة السياسية جذورا أقدم. ويعود ذلك إلى الطابع “التبادلي” للمرحلة الانتقالية التي هي بالتحديد، وفقا للرئيس سعيّد، أحد أسباب المشكلة.
لتفادي العودة إلى دكتاتورية أوتوقراطية أو برلمانية، قسّم الدستور السلطات وأضفى نوعا ما طابعا دستوريا على إلزامية الإجماع. ولكن منذ ذلك الحين، عِوضَ إجماع يتجاوز المصالح الذاتية، سادت نسخة “تجارية” للإجماع حيث سعى كل واحد إلى الحصول على أكبر قدر من الأرباح. وكان ذلك بمثابة أخذ وعطاء بين النهضة التواقة إلى الإدماج والأمن والنخب القديمة، التي مثلها لوقت ما حزب “نداء تونس” والرئيس الباجي قايد السبسي، الباحثة عن “رسكلة” سياسية وحماية. لم يكن هذا “الإجماع” في أي وقت في خدمة مشروع تحويل النموذج الاقتصادي. والسبب واضح، إذ ليس لأي قوة سياسية مشروع من هذا النوع. ولم يسمح هذا الإجماع حتى بتنفيذ “توصيات” المانحين الذين بدأ صبرهم ينفد أكثر فأكثر.
كانت النتيجة أن تغير كل شيء حتى لا يتغير شيء. لقد تدعمت أسس اقتصاد الريع الذي يحتكر الأعمال التجارية المربحة والقروض والتراخيص لبعض العائلات. فمن نظام يخدم السلطة السياسية الذي كان عليه قبل 2011، تحول إلى سيد هذه السلطة. في غياب القدرة على تحسين أوضاع غالبية التونسيين، اكتفت الحكومات المتعاقبة بشراء السلم الاجتماعي وابتلعت التمويلات الدولية التي كان من المفترض أن توجه لدعم الإصلاحات، بينما كانت الإدارة عاجزة عن تنفيذ مشاريع الاستثمار إلى درجة أن مليارات الدولارات من التمويل لم يتم صرفها أبدا.
يعتبر تدهور الوضع المالي الذي يظهر من خلال انهيار التصنيف السيادي لتونس ـوهي على عتبة الخطر النهائي المتمثل في التخلف عن تسديد الديونـ نتيجة لهذه العشرية من الجمود. أصبح المانحون يشكون جديا في قدرة الحكومات على اقتراح وتنفيذ خطة الإصلاح الذي يشترطها الصندوق الدولي لتقديم مساعدته. ويعد ذلك شرطا لكي تتمكن الدولة من الاستمرار في الاستدانة لدى دول وأسواق أجنبية لتمويل تسييرها. جاءت الكارثة الصحية لتجسد بشكل مأساوي في حياة التونسيين نتيجة هذا الفشل الجماعي المتمثل في تدهور الخدمات العمومية وغياب التنبؤ واللامبالاة، إن لم نقل عدم كفاءة الحكام، والطابع العقيم للمناوشات بين الأحزاب السياسية التي تعطي الحياة البرلمانية مشهدا مثيرا للازدراء عنها. وقد عجلت هكذا بالتعبير عن غضب تراكم طويلا وكان وقودا للمظاهرات، مقدمة انقلاب قيس سعيّد السياسي. فالخطر الداهم كان ها هنا، في الانهيار الأخلاقي والاجتماعي والمالي والمؤسساتي للبلاد.
شكلت وضعية “الأزمة العضوية” هذه “لحظة قيصرية” بامتياز، مواتية للجوء إلى قائد يكلف بمهمة إعادة بناء نظام سياسي متهالك. كان قيس سعيّد مرشحا معينا لوظيفة القيصر. فعلى الرغم من نقاط ضعفه، تجاوز الخط باتخاذ قرار حاسم فتح مسلكا فيما كان يعتبر قبل 25 يوليو/تموز طريقا مسدودا.
دعم شعبي لا جدال فيه
عاش العديد من التونسيين هذا المرور إلى الفعل على أنه خلاص. لقد تجاوزت البهجة الشعبية التي أيدت إعلان قيس سعيد الانتماءات الاجتماعية والحساسيات الأيديولوجية، وهو أمر لا يمكن الاستهانة به من وجهة نظر ديمقراطية. كما كان الحال بعد الساعات والأيام التي تلت انتخاب قيس سعيّد بنسبة 73% من الأصوات، هناك تعبير عن شعور بالارتياح والأمل في التجدد الجماعي. فبغض النظر عما يمكن أن يقترحه بصفة ملموسة، فتح قيس سعيّد الباب لحالة من التجنيد واليقظة والاقتراح، وهي نقيض الخمول الذي قد ترسخ من جديد قبل 25 يوليو/تموز. نجد مثالا عن هذا التحول الذاتي في وجهة نظر رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك: “تونس قبل هذا التاريخ ليست تونس ما بعده، كل الذين كانوا يصطدمون بالجدران عندما يريدون تغيير الأمور سيكونون قادرين على المضي قدما، أما الذين كانوا يعانون صعوبة في النوم سينامون بشكل أفضل. سيتمكن الجميع من العودة إلى العمل”.
بالمقابل تعد المحاولات المتسرعة لرؤساء البلديات ومسؤولي الإدارات لإتلاف ملفات مُدينة ابتداء من الاثنين 26 يوليو/تموز مؤشرا قويا عن الخطر الذي يمثله هذا التغيير السياسي على الفساد المستشري. في تصريح يطالب بضمانات ديمقراطية من قيس سعيّد وخاصة باستقلالية القضاء، ذكرت جمعية القضاة التونسيين بأن “عملية الانتقال الديمقراطي والحكومات المتعاقبة منذ الثورة” فشلت في “تلبية التطلعات الأصيلة للشعب” في جعل النظام القضائي يطابق الدستور، وتكريس استقلالية القضاء. كما أنها “مست بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمساءلة في مجال مكافحة الفساد”.
في هذه الظروف، ترن بمرارة المطالب بـ“العودة السريعة إلى العمل الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية” المتكررة في تصريحات الحكومات الغربية في آذان غالبية التونسيين الذين يرون بأنها سبب فقدان أملهم. فهذه النظرة القانونية الضيقة تهمل ما هو أساسي: العودة إلى الوضع القائم سابقا تعني العودة إلى أسباب الأزمة.
والآن، ما العمل؟
هل لقيس سعيّد حلولا يقدمها؟ لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ذلك. من بين دخلاته الأولى في المجال الاقتصادي، ناشد رئيس الجمهورية الواجب الأخلاقي للتجار والصيادلة في تخفيض الأسعار قصد تخفيف العبء على التونسيين. ولكنه لم يجند الأدوات التقنية للسياسات العمومية التي تسمح بتحقيق ذلك. بصفة عامة، بمن سيحيط قيس سعيّد نفسه لتنفيذ مشروع اقتصادي ووفق أية رؤية؟ كيف ينوي استرجاع ثقة المانحين؟ هل بالتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية؟ هل بالتصدي لهروب رؤوس الأموال الذي بدأ بالفعل؟ كيف ينوي إصلاح دولة غارقة بأثقالها البيروقراطية؟
أشار سعيد في خطابه مساء الأحد إلى مشروعه المتمثل في “قلب هرم السلطة”. من الصعب تصور أن الأحزاب السياسية في البرلمان ـالتي يتجاهلها الرئيس تماما منذ تفعيل المادة 80ـ ستقبل بتقويض نفسها بالتصويت لهذا المشروع. هل ينوي قيس سعيد المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء، متحررا هكذا بشكل معلن هذه المرة من الإجراءات المنصوص عليها في الدستور باسم الشرعية الثورية؟ كم من الوقت يحتاجه لاستكمال هذه الأعمال الجبارة؟ دون شك أكثر من 30 يوما.
الخطر السلطوي
بمهاجمته مصالح اقتصادية وسياسية قائمة، سيواجه الرئيس حتما مقاومة وضربات ملتوية. كيف سيتعامل معها؟ وعندما تأتي لحظة “ما بعد السُّكر” وخيبة الأمل، كيف يمكنه توجيه الغضب؟
هنا يكمن البعد الثاني من الجواب. فعلى الرغم من الدعم الشعبي الأكيد الذي يحظى به، ماذا سيكون أثر الوقت والديناميكيات السياسية على هذه السلطة الشخصية؟ مثل ما هو الحال بالنسبة للحروب، الدخول في حالة الاستثناء أسهل من الخروج منها. فبعد تذوق سهولة ممارسة السلطة بدون حدود، سيكون من الصعب التخلي عنها عندما تبدأ الصعوبات الحقيقية. يعد تصحيح مسار ديمقراطي من قبل رجل واحد بدعم من الجيش تناقضا ظاهريا. صحيح أن قيس سعيّد ليس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي هو نتاج خالص لجيش يمتلك كل المصالح الاقتصادية والمستعد لإعدام ألف متظاهر. غير أن دعم الانقلاب من قبل دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة لا يُعد أمرا عرضيا. بدخوله في هذه المغامرة والحال أن البلاد على وشك التخلف عن تسديد الديون، وضع رئيس الدولة نفسه في ميدان صراعات جيوسياسية هي في أوج إعادة التشكيل. هل تسمح الجزائر للنفوذ المصري أن يعمل داخل المنطقة المغاربية؟ هل ستشترط الولايات المتحدة تجديد مساعدتها باستمرار العملية الديمقراطية؟ هل ستسمح للرياض بدعم نهج تسلطي محتمل في الدولة الوحيدة التي قُدمت على أنها مثال للديمقراطية في العالم العربي؟
إحدى مفارقات قيس سعيّد التي أشار إليها مايكل عياري في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية في مارس/آذار 2020، هو أن خطابه يمس طيفا واسعا جدا من الرأي العام. ففي طرف أقصى، له صدى عند مكون شعبي من المجتمع، مهمش في نفس الوقت بسبب النموذج الاقتصادي والديمقراطية التمثيلية. وفي الطرف الأقصى الآخر، فهو يستجيب لطلبات استرجاع الدولة التي أفرغت بسبب الاختراقات الحزبية، والتي يحملها ذوو الحنين من دستوريي النظام السابق.
وقد أكدت عبير موسي، زعيمة حزب الدستور الحر، الذي ينتسب إلى زين العابدين بن علي، بأن ما قام به قيس سعيّد يتطابق مع ما تقترحه. يلتقي هذان الطرفان في جعل حركة النهضة كبش فداء الأزمة، إذ يتهمها البعض بأنها “سرقت” الثورة، في حين يتهمها الآخرون بأنها “سرقت” الدولة“. وقد أصبح التعبير يتم بدون لف، من طرف مدعمي قيس سعيّد، عن مواقف عنيفة مناهضة للنهضة تذكر بأسوأ ساعات السياسة الاستئصالية لبن علي قبل 2011. فالرئيس يتمتع إذا في نفس الوقت بجزء من” الشرعية الثورية“وبجزء من الشرعية”المضادة للثورة”.
إلى أي حد سيؤثر هذا الجانب الأخير المضاد للثورة على تطوره المستقبلي؟ هل سيستمر هذا التقارب أم على العكس سيتمزق؟ وفي هذه الحالة ماذا ستكون كلفته السياسية وكيف سيتعامل معه؟ ولتوسيع الإشارة إلى مفهوم القيصرية، كان أنطونيو غرامشي يميز بين شكلين منها: “أحدهما تقدمي والآخر رجعي. في الحالة الأولى، يختل التوازن لصالح القوى التي تدفع التركيبة الاجتماعية نحو درجة أعلى من الحضارة، وفي الحالة الثانية تكون استعادة ماضوية سيدة الموقف”. من السابق لأوانه في الوقت الحالي الفصل بخصوص هذا التضارب.
هل يمتلك قيس سعيد الوسائل لكي يكون المنقذ؟ هل سيتمكن من تجنب التحول إلى طاغية؟ تونس 2021 ليست تلك التي كانت سنة 1987، عندما خلف بن علي الحبيب بورقيبة على رأس نظام تسلطي قائم. اليوم، حتى وإن كانت الديمقراطية التونسية الشابة تعاني من اختلال وظيفي، فهي قد غيرت الممارسات والتطلعات، وسمحت بنمو مجتمع مدني منظم ومؤثر، وعودت جزءا كبيرا من المواطنين على رفض حرمانهم من حقوقهم أو كرامتهم. في المقابل، سيكون لخيبة أخرى للأمل الذي أطلقه قيس سعيّد تكلفة سياسية رهيبة.
صحفي مراسل في تونس
—————————–
تونس بعد منعرج الفصل 80: المحاسبة قبل المصالحة
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
تمحورت كل خطابات الرئيس قيس سعيد منذ الأحد 25 جويلية حول ثنائية الإصلاح والمحاسبة: إصلاح الخراب الذي حل بالدولة ومحاسبة من تسبب في ذلك، وهو يقصد هنا التحالف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة بمعية شركائها في حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة. إلى حد كتابة هذه الأسطر لم تنطلق خطوات المحاسبة فعليا باستثناء تنفيذ بطاقات جلب وتنفيذ أحكام قضائية في حق بعض النواب (ياسين العياري وماهر زيد وفيصل التبيني ومحمّد العفاس وغيرهم)، وهو ما يضعف حجة المعسكر الداعم لإجراءات الرئيس قيس سعيد باعتبار أنه لم يبدأ فعليا في محاسبة المسؤولين الحقيقيين على تدهور الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي والصحي من سياسيين ومسؤولين في الدولة ورجال أعمال نافذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد ويستفيدون من منظومة الريع الاقتصادي.
المحاسبة قبل المصالحة
وأمام غياب خطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وامتناع الرئيس قيس سعيد عن التصريحات الإعلامية مما يزيد من الغموض المحيط بالرئيس وإجراءاته المنتظرة، بدأت أطراف من داخل النهضة بالترويج لإمكانية عودة عمل البرلمان مع انتهاء مهلة الشهر في إطار خطة متكاملة ”لاستعادة الديمقراطية“، وهي في الحقيقة تمهيد لعرض مصالحة بين النهضة والرئيس يتم بمقتضاها عودة البرلمان مع تعهد بالمصادقة على كل ما قرره ـ وسيقرره ـ قيس سعيد وغض النظر عن مسار المحاسبة الذي يتمسك به الرئيس والداعمون له. فقد ركز قيس سعيد في خطاباته على المحاسبة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاسبة النواب في القضايا والتتبعات العدلية في حقهم والتي توقفت بموجب الحصانة التي يمنحها الدستور التونسي لنواب الشعب.
وبغض النظر عما ستبوح به الرئاسة في الساعات والأيام القادمة، فإن التراجع وتوزيع الأدوار الذي اعتمدته حركة النهضة منذ تفعيل الفصل 80 يعبر عن مأزق حقيقي تعيشه الحركة التي تجد نفسها لأول مرة خارج السلطة منذ انتخابات أكتوبر 2011، فهي تجند صفحاتها ومدونيها و”النخبة“ المقربة منها في الداخل والخارج للترويج لما تعتبره انقلابا على الشرعية الدستورية، وفي نفس الوقت تبعث برسائل للداخل والخارج وللرئيس قيس سعيد بأنها مستعدة لمراجعات عميقة وشاملة وإعادة ترتيب بيتها الداخلي بفعل ”الصدمة“ التي أحدثها تفعيل الرئيس للإجراءات الاستثنائية حسب ما صرح به المتحدث السابق باسم النهضة عماد الحمامي. بل إن القيادي في النهضة والمعارض لسياسات راشد الغنوشي سمير ديلو أشار بكل وضوح في حوار مع إذاعة شمس أف أم الأربعاء 4 أوت، إلى أخطاء جسيمة ارتكبتها حركته على غرار التسرع في تنحية حكومة إلياس الفخفاخ وهو ما أضر بمصلحة البلاد، بالإضافة إلى المصادقة على قانون المصالحة والإصرار على المصادقة على الوزراء المرفوضين من رئيس الجمهورية في التعديل الوزاري ”المعلق“.
الطريق إلى الفصل 80
الطريق إلى الفصل 80 مر بعديد المراحل والأزمات خاصة بين الرئيس قيس سعيد من جهة ورئيس الحكومة المقال وحليفه راشد الغنوشي من جهة أخرى، وبدأت ملامح هذه الأزمة منذ إطلاق الترويكا البرلمانية (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) مساعيها لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ وتقديم هذا الأخير استقالته لدى رئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020. وبلغت هذه الأزمة مداها عندما استمالت حركة النهضة هشام المشيشي وأبعدته عن رئيس الجمهورية الذي اختاره لتشكيل الحكومة، منذ ذلك التاريخ وصلت الأزمة بين الطرفين إلى نقطة اللاعودة وشحت اللقاءات بين سعيد والغنوشي حتى بلغت قيام وساطات لعقد لقاء بين الرجلين (وساطة لطفي زيتون التي توجت بلقاء جمع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان في 24 جوان الماضي) بعد انقطاع هذه اللقاءات طيلة ستة أشهر. وساطة لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الرجلين، بل إن قيس سعيد كان يشير في كل خطاباته إلى أن محاسبة الفاسدين و”دويلات الفساد“ التي تتحكم في مصير تونس هي الأولوية القصوى من أجل إنقاذ ما تبقى من الدولة.
وترافقت هذه الفترة مع غضب شعبي واسع بفعل تدهور الوضع الصحي وعدم قدرة الحكومة على توفير مستلزمات صحية على غرار الاكسجين الذي نفد مخزونه في ذروة انتشار فيروس كوفيد 19 وهو ما تسبب في وفاة العشرات من التونسيين، بالإضافة إلى عدم مرافقة الفئات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وغلق الأسواق والمحلات، والتدهور الشامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. كل هذا يمر دون تحرك جدي من الحكومة والحزام الداعم لها، بل إن هذا الحزام ظل يخوض معارك سياسوية وحزبية ضيقة داخل البرلمان وخارجه ومارس الابتزاز ضد رئيس الحكومة المعفى هشام المشيشي من أجل التعيينات في الإدارة والولايات والمعتمديات والشركات العمومية، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب شيئا من الجدية في معالجة أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
مكافحة كوفيد-19 في تونس: حكومة المشيشي، متراك البوليس عوض التلقيح
بل إن الحكومة وبدعم من حزامها السياسي تعاملت مع مطالب الشعب بالقوة الأمنية والاعتقالات والتعذيب وضرب حرية التظاهر والتعبير وتحصين مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من العقاب. كل هذه المعطيات تسببت في حالة من الغليان الشعبي ضد الحكومة وحزامها السياسي وخاصة النهضة التي تحملت فاتورة الفشل العام الذي تعيشه البلاد منذ عشر سنوات.
قد تكون إجراءات قيس سعيد الأخيرة قفزة في الهواء أو خطوة غير محسوبة العواقب قد تعيدنا إلى الوراء، وقد تضعنا هذه الاجراءات أيضا أمام خطر الانفراد بالسلطة وإعادة الحكم الفردي المطلق من قبل رئيس الجمهورية، لكن التفاعل الشعبي والسياسي معها أثبت أن الفترة تحتاج إجراءات تعيد ثقة المواطن في الدولة وإعادة الاعتبار للديمقراطية الحقيقية التي تقوم على أساس حماية مصالح الشعب والعدالة للجميع على قدم المساواة وانهاء الإفلات من العقاب وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، وخاصة توفير الحد الأدنى من الكرامة للمواطنين، وهو ما كان مفقودا في الفترة السابقة.
——————————–
=======================
تحديث 12 آب 2021
————————-
عن “25 جويلية” والحاجة إلى إصلاح البرلمان التونسي/ سالم لبيض
لا أحد يستطيع أن يكابر اليوم، ويغضّ بصره عمّا طرأ على البرلمان التونسي من تجميد، وتجريد نوابه من حصانةٍ ظنّ بعضهم أنها واقية لهم من كل نوائب الدهر، لمجرّد أنها انتبذت لها مكاناً قصياً في صفحات الدستور التونسي لسنة 2014، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيّد يوم 25 جويلية (يوليو/ تموز) المنقضي. تمسّك نواب تونسيون كثيرون بالحصانة شكلاً، وأسقطوها عن أنفسهم أخلاقاً وقانوناً ومبادئ ووعوداً انتخابية منذ دخولهم في يومهم الأول البرلمان التونسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية سنة 2019. واعتقدوا أنهم ظل الله في الأرض، يمتلكون عصمة الأئمة وحلول المتصوّفة ونقاءهم الروحي، وأن لا أحد يستطيع مراقبتهم ومحاسبتهم وثنيهم عن غيّهم الذي هم بالغوه، فانحرفوا بالبرلمان عن وظائفه المقدّسة دستورياً، وحوّلوا قاعاته إلى دهاليز لحياكة المؤامرات على الشعب الذي انتخبهم وفوّض إليهم أمره، قبل أن تحبّر تلك المؤامرات نصوصاً تشريعية تُشتم منها رائحة مصالح اللوبيات وجماعات الفساد والإفساد في الأرض. وبدلاً من جعل الجلسة العامة للنقاش الحر العقلاني وإنتاج القيم السامية التي تستحيل قوانين بنّاءة، منتجة للحياة ومنظمة لها، وموفرة الحماية للمجتمع والدولة، تحوّلت قاعة الجلسات العامة إلى فضاء لإهانة الوزراء والحكومات، وترذيلهم أمام كاميرات التلفزات المحلية والعالمية، حتى باتوا يتحاشون الجلوس في حضرة برلمانٍ هو من منحهم الثقة ليكونوا وزراء وحكومات، ونصب المحاكمات لرئيس الجمهورية، والتفنن في المماحكات اللفظية، وانتقاء أبشع النعوت والصفات التي تستهدفه إساءة وتحقيراً، واستيلاء رئيس المجلس، راشد الغنوشي، على صلاحياته، وإلى حلبة للملاكمة والعراك والضرب والركل والعنف والسبّ والشتم والقذف والاعتصام العشوائي والاعتداء على الآخر الوطني، بكل ما تحمله تلك الكلمة من شحنة الاختلاف والتنوع والتعدّد والتعايش والتداول، والعدوان على الآخر الأجنبي في كل أصقاع الدنيا الذي تربطه بالتونسيين روابط الأخوة والهوية والدين وحقائق الإنسانية والتعاون بين الشعوب.
ولا يتسع هذا المقال لوضع تصنيف دقيق لما ارتكبه بعض البرلمانيين التونسيين من جرائم في حق ناخبيهم وشعبهم وتجاه أنفسهم سنتين، كتمجيد الإرهاب وتحقيق منافع شخصية وعقد صفقات فاسدة لأنفسهم وشركاتهم الخاصة والتحايل على الدولة والأفراد، ما استوجب صدور طلبات من القضاء لرفع الحصانة عنهم، أخفاها رئيس المجلس، حتى صار البرلمان التونسي، وهو في الأصل مفخرة الديمقراطية التونسية وأحزابها الوطنية، أضحوكة ومسخرة لدى عامة الناس، وقادتهم المحليين ولدى النخب الفكرية والسياسية والإعلامية والنقابية التي طاول جلّها عدوانية بعض النواب وأذاهم الذي أبى أن يتوقف، قبل أن تنقلب إلى عدوانيةٍ مضادّة وكُفر بهذا البرلمان، ورغبة شعبية جامحة في إيقاف عمله وحله، فقد تحوّلت المؤسسة التشريعية إلى كابوس مزعج للناس في أيامهم ولياليهم، و”أغلقت أمامه قلوب الناس، قبل أن تغلق بوابته مدرّعة عسكرية” على حد تعبير القيادي النهضوي، سمير ديلو، لموقع الصباح نيوز في 9/8/2021.
ولم يتمكن راشد الغنوشي الذي يتولى رئاسة المجلس التشريعي بحزب فاز بـ 20% من المقاعد، وبأغلبية هشّة براغماتية متهافتة ذات نزوع غنائمي، من حسن تسيير البرلمان، فقد أبدى انحيازاً حزبياً وأيديولوجياً بائناً حرمه لذّة الحياد الذي يستوجبه منصب قيادي وسيادي في الدولة، وتفرضه مقتضيات التعالي فوق الصراعات الحزبية، وميل الكتل البرلمانية نحو الانطواء والتصادم لتحقيق منفعة فئوية والعيش على وهم التعاطف الشعبي، وأظهر عجزاً في التسيير والإدارة، منه ما هو ناتج من انعدام تجربة الدولة لديه ومعرفة نواميسها واستبطان إكراهاتها، ومنه ما هو مرتبط بضعف القدرات الشخصية لشيخٍ دخل للتو عقده التاسع، من دون نسيان مقاربته في التمكين من مفاصل الدولة لأبناء التنظيم، بمن في ذلك من تعوزه مبادئ الكفاءة والنزاهة والمعرفة والمسؤولية والروح الوطنية، ما جعله عرضةً لسحب الثقة في أكثر من مناسبة.
ومن العبث بعد مرور أسبوعين على تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الفصل الـ 80 من الدستور التونسي، المتعلق بالخطر الداهم، البقاء في مربع النقاش الأول والاكتفاء بنعت الإجراءات الاستثنائية بالانقلاب أو عدمه. ولكن من المهم جداً الاعتراف بأن واقعة يوم 25 جويلية، وحراكها الاحتجاجي الذي أدّى إلى الإجراءات المذكورة، كان سيقع يوم 26 أو يوم 27 أو بعد ذلك التاريخ، مهما كان لون فاعله، لو تأخر قيس سعيّد في اتخاذ قراره. ويبدو أنه استبق خطة نهضوية رشح أنها تحمل عنوان “فلسفة العزل” لإزاحته عن الحكم وعزله مطلع السنة البرلمانية المقبلة، فالخطر الداهم كان مؤكّداً، ومراكز القوة والنفوذ في الدولة كانت تتصيد اللحظة المناسبة لتبديل حال الدولة كل لمصلحته. ولقد أشار الكاتب، في مقاله في “العربي الجديد”، في 2021/6/27 بعنوان “الأزمة المالية ونزاع النفوذ في تونس” إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية مهدّدة بالسقوط، وأن تونس في ظل عجز المالية العمومية ودرجة المديونية عالية المخاطر وبلوغ الدولة حافّة الإفلاس وانتشار رائحة الموت بسبب العجز عن توفير اللقاحات، قد تجد نفسها تحت الوصاية الدولية، أو بين فكّي كماشة “فإما انهيار الدولة أو عودة الاستبداد”. وأورد مقالٌ ثانٍ نشره “العربي الجديد” يوم 2021/7/21، أن تونس تشهد “حركة احتجاجية – افتراضية حادّة وعامة من مختلف الشرائح الاجتماعية والنخبوية، ضدّ حركة النهضة، الإسلامية، بلغت حدّ الدعوة إلى اعتماد ذلك التاريخ موعداً للنزول إلى الشوارع، وإسقاط الحزب الإسلامي من الحكم، وتغيير النظام السياسي برمّته”، وهو ما حصل فعلاً يوم 25 جويلية (يوليو/ تموز).
تجاهلت حركة النهضة وحلفاؤها ذلك الاحتجاج الافتراضي – الشعبي الذي ترجمه أصحابه على أرض الواقع لاحقاً، وتجاهلت كل القراءات الاستشرافية لما ستعيشه تونس يوم 25 يوليو وما بعده، واكتفت بتأويلية تجريمية لما يحدث، على غرار السردية الاتهامية والمؤامراتية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي للثورة التونسية، منذ انطلاقتها الأولى في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 في مدينة سيدي بوزيد. فحركة النهضة هي من ورث النظام القديم وحزبه التجمّع الدستوري الديمقراطي، وأسلوبه في الحكم ومقاربته المجتمعية التي تنسج خيوطها نظرة أمنية بالدرجة الأولى. ولذلك عاشت تجربة “التجمّع الدستوري الديمقراطي” في حرق المقرّات، وربما يطاولها المنع النهائي إذا هي استمرّت بالوجوه القديمة والفكر المتآكل ونهم الغنيمة والمناصب وشبهة تنظيمها السرّي، ولم تصلح حالها جذرياً.
استبطن النهضويون، ومن والوهم، المقولة الستالينية العتيقة، معتقدين أنّ البرلمان التونسي الذي يمثل مطبخ السياسة ومحورها قلعة محصنة لا تفتح إلا من الداخل، فإذا به أوهن من بيت العنكبوت، حتى إنه لم يستطع الصمود دقائق أمام قرار أعلى هرم السلطة التنفيذية بتجميده. ولم تفلح صورة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، أمام القضبان الحديدية وهو يتودد لأحد الجنود فتح الأبواب المغلّقة في كسب تعاطف قواعد حزب النهضة وعامة المواطنين للالتحاق به، وممارسة ما يستدعيه الحدث من اعتصاماتٍ وضغوط، وقد ترسّب الفساد في مختلف خلايا البرلمان ومؤسساته وتشريعاته، وسلوك بعض نوابه ممن فازوا بمقاعد بواسطة الغش الانتخابي، كما هو مثبت في التقرير العام لمحكمة المحاسبات عن نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 الصادر سنة 2020، الأمر الذي جعل من تلك الدعوة مجرّد صرخةٍ في واد سحيق.
كتب المفكر المغربي محمد عابد الجابري، في مؤلفه “في نقد الحاجة إلى الإصلاح” (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005) “مفهوم الإصلاح في المرجعية الأوروبية يرتبط بتغيير الصورة، وإذا اعتبرنا الدولة صورة لمجموعة من السكان فإن الإصلاح في أي مجتمع يجب أن يتجه أولاً وقبل كل شي إلى الدولة”. وعلى الرغم من اختلاف هذا المفهوم عمّا هو سائد في المرجعية العربية الإسلامية، حسب الجابري، الذي يربط “الإصلاح بالفساد في الشيء، والعودة إلى الحال التي كان عليها قبل طروء الفساد عليه”، فإن البرلمان التونسي يستوجب الإصلاح، بما هو مؤسسة للدولة وجب أن تكون صورة ومرآة عاكسة للهواجس الشعبية وإرادة الشعب، أو أغلبيته على الأقل، وبتطهيره مما طرأ عليه من تعفّن أخلاقي وانهيار سياسي وسقوط قيمي كان سبباً في التعجيل بتجميد نشاطه بالكامل، ووضع مقرّه تحت طائلة الحماية الأمنية والعسكرية.
وسواء استقر الرأي لدى الرئيس قيس سعيّد، بإعادة البرلمان الحالي إلى دورة الحياة السياسية أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، فإن عودة المؤسسة التشريعية على حالها القديم وبالرئاسة الفاقدة الاستقلالية وشروط حسن التسيير وبالنواب أنفسهم الذين علقت ببعضهم شوائب سيرية وسوء السلوك واتهامات وقضايا وضعف في الشهادات العلمية والقدرات المعرفية والكفاءة السياسية، وبنظام داخلي أعرج لا يمكّن من تأمين عمل المجلس، هو ضرب من الخبال والعبث.
يحتاج البرلمان التونسي إلى وعي نوابه النزهاء بدوره المحوري في صناعة السياسة وحماية التجربة الديمقراطية الفتية من الانهيار، فهو نظرياً على الأقل صمام أمان مختلف الحريات الفردية والجماعية وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات والتداول السلمي على السلطة. وإن الدعوات إلى استبدال الدور البرلماني بالعودة إلى النظام الرئاسي وفق دستور 1959، أو غيره من الدساتير تنسى أو تتناسى أن الستين سنة التي تلت الاستقلال سنة 1956 لم تكن أقل مأساويةً من العشر سنوات الأخيرة، كما هو مدوّن في كتاب توفيق المديني عن المعارضة التونسية، وفي تقرير اللجنة التي ترأسها عبد الفتاح عمر عن الفساد والرشوة في تونس، وأن دور النخب الوطنية هو مساعدة الرئيس سعيّد على البقاء في حدود الفصل الثمانين والتزام الدستور وإنهاء الحالة الاستثنائية في آجالها المحدّدة بعد تطهير الحياة السياسية التونسية التي طمرتها آثام السياسة ولوّثتها مستنقعات المال والإعلام الفاسدين.
العربي الجديد
——————————
وعود قيس سعيّد التي لا تتوقف .. ولا تتحقق/ مالك ونوس
إذا كانت مصاعب تونس الحالية من نواتج عدم حسم الملفات الموروثة من نظام ما قبل الثورة، والتي استمرت ضاغطة ومعيقة أي تحوُّلٍ يقطع مع ماضي حكم الاستبداد، فإن “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها الرئيس، قيس سعيِّد، في 25 الشهر الماضي (يوليو/تموز)، لم يرشَح منها خطة للحل، مع مضيّ أسبوعين على خطوته. ويتكرَّس هذا الواقع، على الرغم من أن تونس نعمت بعد انتصار ثورتها، سنة 2011، بأجواء ديمقراطية أزالت بعض ممارسات الاستبداد التي أرهقت أرواح التونسيين عقودا، لكنها لم تحل مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية التي أرهقت أجسادهم. وكان لافتاً غياب الخطط الحكومية الكفيلة بحل تلك المشكلات، والروادع الشعبية والأهلية التي تمنع الانقضاض على التجربة الديمقراطية، لذلك لا يلوح سوى الغموض مع خطوة سعيد التي يراها بعضهم محاولةً للتفرّد بالسلطة.
تعوَّدنا على إطلالات الرئيس قيس سعيِّد ساخطاً ومتذمِّراً، يلهج بالوعيد والتهديد وبإجراءاتٍ لمحاسبة المقصِّرين والفاسدين، غير أن هذا السخط لم يأخذ طريقه إلى الواقع على شكل قراراتٍ، تأتي بالفاسدين للمثول أمام المحاكم التي تسرد عليهم التهم التي أوجبت توقيفهم أمام القضاء وفي الزنازين. وفي كل خطابات سعيِّد، كانت هنالك ملامح لأشباحٍ يعيثون في البلاد فساداً، ويتحمّلون مسؤولية فقر عبادها وتخلّف إداراتها، من دون أن يسمّي أيّاً منهم أو يحاسبه. وفي هذا السياق، كانت دعوته الشهيرة التي قال فيها: “لا تتركوهم يتاجرون بفقركم”، والتي أطلقها عشية الاحتجاجات المطلبية، أواسط يناير/كانون الثاني الماضي، ووجّهها للمحتجين الذين زارهم في الأماكن التي شهدت احتجاجهم. يومها قال لهم: “أعرف الأطراف التي تتاجر بالبؤس وبالفقر وتسعى إلى توظيف الشباب” (استغلالهم)، غير أنه وبعد مضي ستة أشهر على تلك الدعوة، وعلى إقراره بمعرفة المسؤولين عن فقر مواطنيه، لم يحاسب أي متاجرٍ بالفقر، ولم يتخذ أي إجراءٍ يغير من واقع هذا الفقر، فهل ستفعل ذلك تدابيره الاستثنائية؟
وفي كلمته التي ألقاها في اليوم التالي للتدابير الاستثنائية التي اتخذها، عاد الرئيس سعيِّد إلى اللغة ذاتها حين قال: “هنالك لصوصٌ يحتمون بالنصوص”، وكما في المرات السابقة، لم يُسمِّ أولئك اللصوص. ثم زاد في وعيده، حين أردف قائلاً: “صبري نفد وكان لا بدَّ من استعادة دولة القانون”. وما دامت خطوة استعادة دولة القانون قد اتّخذت فلماذا لا يحاسب اللصوص منتهكي القوانين؟ كذلك، إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب لتسميتهم بالاسم وتوقيفهم لمحاسبتهم، فمتى يكون؟ ومع التدقيق في خطاباته، نكتشف أن الرئيس لا يعرفهم فحسب، بل هو يعرف عددهم بدقة؛ إذ أعلن، خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بعد ثلاثة أيام من اتخاذه التدابير إياها، عن عدد 460 شخصاً نهبوا أموال الدولة، وقال إنه عرض عليهم تسويةً تقضي بإعادة هذه الأموال.
يدين الرئيس سعيِّد نفسه، في كل إقراراته وكلامه عن معرفته بالفاسدين والمقصّرين واللصوص، كونه لم يتخذ أي إجراء لتغيير واقع الحال خلال سنتين أمضاهما في رأس السلطة. وقد قال في كلمته بعد إعلان التدابير، في سياق حديثه عن تحرّكات الفاسدين: “كنت أعلم الكثير وأنا ملازمٌ للصمت لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور”. ويعدُّ هذا الكلام في لغة القضاء عملية تستُّرٍ على مخرّبي اقتصاد البلاد وناهبي أموالها. وكانت فترة السنتين هذه كفيلةً بأن يفتح جميع الملفات ويحاسب الجميع، حتى المتمارضين المتغيبين عن أعمالهم. وإنْ لم يفعل ذلك، فإن هذه المدة كانت كفيلة بأن يضع خلالها خططاً مستقبلية لحماية دولة القانون عبر تدابير، غير تدبير الانقضاض على السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وخرق الدستور، كما فعل قبل أيام. وفي هذا السياق، فإن تقديم شخصٍ واحدٍ للتحقيق والمحاكمة على فساده كان كفيلاً بأن يجعل السبحة تكرّ، ويقاد جميع الفاسدين إلى المحاكم والسجون. وكان يمكن، خلال فترة حكمه هذه، إعادة أموال الدولة المنهوبة، والتي وعد بإعادتها، لتنعكس تنميةً وبحبوحة يعيشها التونسيون، غير أنه لم يفعل ذلك، بل وكما لم يتقدّم ببرامج وخططٍ في أثناء حملته الانتخابية، أو بأي خطة لمكافحة الفساد، لم يتقدّم، حين أصبح في سدّة الحكم، بخطة للتنمية أو للخوض في مسألة العدالة الانتقالية لإقفال ملفات ما قبل الثورة، مستمرّاً بالحديث في العموميات.
لقد كبَّل الرئيس سعيِّد نفسه بالإجراءات التي اتخذها، وهو ما يبرِّر لبعض المحللين توصيف ما حدث بأنه انقلاب الرئيس على نفسه. إذ إنه لم يعيّن رئيس حكومة، بعدما عزل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وبعدما جمَّد عمل مجلس النواب. وهو بذلك يُدخل البلاد في فراغ دستوري وفراغ سلطة بعد تجميد عمل السلطة التشريعية وعزل السلطة التنفيذية. أما حين سيعين رئيس حكومة، لا يوجد برلمان ليمنحه الثقة بعدما جمّد عمل مجلس النواب. ومن الواضح أنه لا يأبه لتداعيات هذه الأعمال على حياة التونسيين المعيشية وأعمالهم، خصوصاً في ظل أزمة كورونا الضاغطة، وأزمات البلاد المالية والاقتصادية، والتي ليست سوى انعكاس للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد على مدى السنتين الأخيرتين، بسبب الصراع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث.
قال الرئيس سعيِّد، في خطاباته ولقاءاته، إنه اتخذ تدابيره استناداً إلى الدستور، غير أن الدستور، وخصوصاً المادة 80 التي استند إليها، تنص على أنه خلال حالة الطوارئ التي يعلنها الرئيس، يجب أن يكون مجلس نواب الشعب “في حالة انعقاد دائمٍ طيلة هذه الفترة”، لكنه جمَّد عمل هذا المجلس فخالف الدستور وجرَّ البلاد إلى أزمة دستورية، وظهرت لديه نيّات التفرّد بالحكم. في هذه الحالة، إذا أراد الرئيس تنفيذ وعوده ومحاسبة الفاسدين، ومنهم من كان في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب الذي رفع الحصانة عن أعضائه، فليس هنالك ما يضمن أو يمنعه من ألا يفتك بجميع معارضيه تحت بند مكافحة الفساد. وبالاستناد إلى الوقائع التي تقول إنه لم يقدّم فاسداً واحداً من الذين يعلم بهم، تصبح الخشية، في هذه الحالة، أن يَقصِرَ حملة المكافحة على المعارضين السياسيين، خصوصاً منهم الذين طالبوا، وما زالوا يطالبون، بمكافحة الفساد والبتّ في مسألة العدالة الانتقالية، وغيرها من الملفات الموروثة التي تمنع القطع مع ماضي تونس ما قبل الثورة، ويترك، بالتالي، الفاسدين طلقاء، بعدما تسلَّق على وعود مكافحتهم للوصول إلى الحكم، ولإعلان تدابيره.
العربي الجديد
———————————
على عتبة انتهاء «شتاء تونس»!/ عماد شقور
هل أُغامر مرة ثانية؟
كانت المغامرة الأولى فور انطلاق شرارة التغيير الجذري في العديد من دول العالم العربي، في الأيام الأخيرة من نهاية العقد الأول من القرن الحالي، ويوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 تحديداً.
ما جرى ويجري في تونس من أحداث متلاحقة، خلال الأُسبوعين الماضيين، وتحديداً: منذ صباح الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، ليست أحداثاً وتطورات هامة فقط، إنها، (في اعتقادي) أحداث تاريخية، تحمل تباشير انتهاء «فصل عربي» وبداية «فصل عربي»جديد. إنها علامات انتهاء «فصل الشتاء العربي» الذي امتد في تونس ليغطي سنوات عقد كامل، (أو لـ»عَشريّة» كما تقول لهجات عرب شمال إفريقيا) مع ملاحظة جوهرية، هي أن «شتاء تونس» هذا، كان صعباً، ولكنه كان أرحم، بما لا يقاس من «شتاءات» ليبيا ومصر واليمن وسوريا، وكان أرحم، إلى حدٍّ ما، من «شتاءات» السودان والعراق، وغيرها من بعض الدول العربية.
لا بدّ من توضيح لمعاني ما تقدَّم من كلمات: حين انطلقت «الشرارة» من تونس، ظهر يوم حادث مُروِّع في النصف الأخير من الشهر الأخير سنة 2010، هي شرارة إقدام الشاب التونسي، محمد البوعزيزي،على إضرام النار في نفسه، احتجاجاً على مصادرة عربته التي كان يبيع عليها الخضار، واحتجاجاً على توجيه السلطة التونسية، (ممثلة بالشرطية التونسية، فادية حمدي) صفعة له، واحتجاجاً على رفض سلطات «ولاية سيدي بوزيد» التونسية، لشكواه ضد تلك الشرطية.
اثارت هذه الحادثة، كما هو معروف، غضباً غير مسبوق في الشارع التونسي، وانتقلت شرارتها لتطال ساحات في العديد من العواصم والمدن العربية، في المغرب العربي كما في المشرق العربي.. ولعلّ أهمها ميدان التحرير في القاهرة.
أطلق مفكّرون وكتّاب في الغرب، بسوء نيّة وطويّة، (في اعتقادي) على تلك الحادثة المؤلمة، وما نتج عنها من اهتزازات فورية وعفوية وعارمة، في تونس، وفي العديد من الدول العربية، اسم «الربيع العربي» وتلقّف العرب، (في غالبيتهم) هذه التسمية الجميلة، في شكلها، وفي ما تشير إليه، وما توحي به، واعتقدوا، مخطئين، أننا فعلاًعلى أبواب «ربيع عربي».
فرحتُ، حدّ النشوة، مثل غيري من عشرات ملايين العرب، بالإستجابة الإيجابية للشارع العربي لحادثة البوعزيزي المؤلمة جداً، ولكنني غامرت حينها، (شفهياً وخطّياً) وقلت لكل من استطعت إيصال قناعتي اليه: لا يمكن الإنتقال من الخريف إلى الربيع مباشرة.. هناك جسر إلزامي لا مجال لتخطّيه، اسمه «فصل الشتاء» الذي يلي فصل الخريف، ويشكل مدخلاً لبداية فصل الربيع.
نتعلم من الطبيعة ونقول: ما يلي فصل الخريف هو فصل الشتاء. وإن كان فصل الخريف هو علامة الذبول والهبوط، على طريق الغياب والاضمحلال، فإن ما يليه ليس فصل الربيع بما فيه من أزهار وبقول وخضار ونِعَم، وإنما فصل الشتاء الذي يزيل غبار الخريف، من جهة، ويروي الأرض ويمكنها من الإنطلاق لبدء دورة إنبات حياة جديدة، مليئة بالخير، من جهة ثانية، لكن فصل الشتاء لا يأتي إلا مصحوباً بعواصف واعاصير وفياضانات وانهيارات وبروق ورعود، من جهة ثالثة. هذا هو قانون الطبيعة، ولا يفيد معه لا تشاطر ولا تجاهل ولا إنكار.
امتد موسم «الخريف العربي» سنوات وسنوات، كنا نحسب فترة جلوس الحاكم العربي على كرسي الحكم، (في «الخريف العربي») بالعقود وليس بالسنين: من عصر/عهد معمر القذافي في ليبيا، إلى حسني مبارك في مصر، إلى علي عبدالله صالح في اليمن، والى زين العابدين بن علي في تونس، وعمر حسن البشير في السودان، وعبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر، اضافة إلى «الحزب الحاكم» في العراق، وفي سوريا، حيث ورّث الحاكم إبنه الحزب والدولة. كان هذا، (وما زال في كثير من الدول العربية) خريفاً عربياً. كان هذا فصل موات. جاز لنا ان نقول بعده: ان عالَماً عربياً دون معمر القذافي، خير من عالَم عربي يحكم فيه القذافي ليبيا ويتحكّم بشعبها. وما ينطبق على ليبيا والقذافي يطال كل الدول العربية التي نعِمت بزوال خريفها، وتلك التي تنتظر زوال خريفها ايضاً. لم تشمل نعمة «زوال الخريف» كل دول العالم العربي. كما لا يغيب عن الذهن ايضاً، أن ما كان عليه حال الدول العربية، مطابق لما هو عليه حال الغالبية العظمى للأحزاب في تلك الدول، يمينها ويسارها على حد سواء: من ميشيل عفلق، في سوريا بداية، ثم في العراق بعدها، إلى خالد بكداش، (أمين عام الحزب الشيوعي السوري على مدى 62 سنة، أي لأكثر من جيلَين، من سنة 1933 لغاية وفاته سنة 1995) ومثلهما غالبية الأحزاب العربية، من الحزب القومي السوري، إلى حزب الكتائب، إلى النّجادة، ووصولاً إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وغالبية الأحزاب في تلك الدول. وبرغم الاختلافات الجذرية والجوهرية بين جميع أصحاب هذه الأسماء والألقاب، إلا أن صفتين اثنتين تنطبقان على الغالبية العظمى منهم: صفة إيجابية: كيف ومتى يبدأون، وصفة سلبية: كيف ومتى يتقاعدون، ويختارون التوقيت الملائم للتّنحّي.
حال الفلسطينيين، على هذا الصعيد، مطابق لحال بقية الحاكمين في دول العالم العربي، وأحزابه ايضا، وقد يكون التميّز الوحيد بين هذين الحالين محصورا في الاسم واليافطة فقط، حيث استبدل تعبير «الأحزاب» في الدول، بتعابير الـ»حركات» و»الجبهات» و»الفصائل» في الساحة. (وبالمناسبة: هذا لا ينطبق على «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» لكنه فاقع الشبه بالنسبة لما هو حال حركة «فتح» وطبعاً ما عداها مثل «الجبهة الديمقراطية» و»القيادة العامة» وغيرهما).
على أن ما يجري في تونس هذه الأيام، هو الشرارة الأولى للتغيير الجذري، وللإنتقال، الذي نأمل أن يكون سلساً، (وغير دمويٍّ على الأقل) من «شتاء تونس» إلى «ربيع تونس».
يواجه الرئيس التونسي، قيس سْعيِّد، (الذي تميّز عن جميع الحكّام العرب، بقوله صراحة وعلانية، إن تطبيع دولٍ عربية لعلاقاتها مع إسرائيل هو: خيانة) في خطواته الجريئة الأخيرة ابتداءً من مساء الخامس والعشرين من الشهر الماضي، فساداً وفاسدين ومفسدين. هذه ليست العقبة الأصعب. انه يواجه «حركة النهضة» ذات الخلفية الدينية الإسلامية، حتى وإن كانت بعيدة، (رسمياً وعلنياً، على الأقل) عن «الإخوان المسلمين».
للتوضيح فقط: كل الحركات السياسية، ذات الخلفية الدينية، والإسلامية منها على وجه الخصوص، عميقة الجذور.
نتعلم من تاريخنا: نشأت في فلسطين وفي لبنان وفي الجزيرة العربية، (في المملكة العربية السعودية هذه الأيام) ما بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر ثلاث حركات سياسية، وقادة سياسيون: حركة «الزيادنة» في فلسطين، ومؤسّسها ظاهر العُمَر الزيداني، وبنَت علاقات مع مصر وفرنسا وروسيا (القيصرية) لكن، وبمجرّد مقتل ظاهر العمر الزيداني، أعاد أحمد باشا الجزّار فلسطين إلى حظيرة السلطنة العثمانية؛ وفي لبنان (جبل لبنان) نشأت وترعرعت «الشّهابية» و»المعنيّة» لكن ما إن زال أصحاب الشخصيات القوية، (أو قل الكارزمية) من هؤلاء، حتى تلاشى وانتهى دور المعنّية والشّهابية؛ ولكن «الوهّابية» التي أنشأها محمد بن عبد الوهاب، في نفس تلك الحقبة الزمنية، في «الدرعية» في نجد، ما زالت قائمة حت ايامنا هذه، وذلك بفضل سبب واحد وحيد، هو انها حركة ذات مرجعية دينية.
لعل ما يفيد في هذا السياق، الإنتباه إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» الذي انطلق سنة 1928، وما زال حاضراً، بقوة في بعض الدول العربية، سواء بوجهه واسمه الصحيح والمباشر والمعلن، أو بـ»أسماء حركيّة» مثل «حماس» في فلسطين، أو «النهضة» في تونس، أو «الرفاه» وبعد ذلك «الفضيلة» وحالياً: «حزب العدالة والتنمية» في تركيا.
نعم.. أُغامر مرّة ثانية وأقول: نحن على عتبة انتهاء «شتاء تونس». وقد نكون على عتبة انتهاء «الشتاء العربي».
كاتب فلسطيني
القدس العربي
———————————-
الاستثناء العربي وليس الاستثناء التونسي/ ياسر أبو هلالة
بقي أسبوعان لنتأكّد من نهاية الاستثناء التونسي، فإذا لم يجتمع مجلس النواب التونسي يكون الرئيس الشعبوي، قيس سعيّد، قد أتم انقلابه. وحتى لو عاد المجلس، فإن التجربة قد كسرت وتظل مهدّدة في أي لحظة أمام رئيسٍ ينكر مبادئ الديمقراطية والدستور والمؤسسات، ولا يؤمن إلا بأفكاره التي تشبه، إلى درجة كبيرة، أفكار دكتاتور ليبيا المخلوع معمّر القذافي. وواضحٌ أنّه مستعد لاستخدام أقسى درجات العنف مع خصومه السياسيين، ولا يتورّع عن ممارسات أي دكتاتور، فالمعارضة لم تُبد أي مقاومة، لكن الاعتقالات خارج نطاق القانون لم توفّر أحداً.
نحن أمام استثناء عربي مستمر منذ عقود، فالديمقراطية لا مكان لها من المحيط إلى الخليج، دول كانت دوننا ديمقراطياً، سواء في أوروبا الشرقية أم أفريقيا أم العالم الإسلامي تقدمت أشواطاً علينا. أكبر بلد إسلامي، إندونيسيا، شهد تحولاً ديمقراطياً، ومنذ عام 1997 وهو ينافس على أن يكون خامس اقتصادي عالمي خلال عقد. في المقابل، لم تصمد تجربة التحول الديمقراطي في مصر أكثر من عام، تونس قاومت عقداً كاملاً وانهارت.
عنون الكاتب جيمس فيرغسون في “فايننشال تايمز” مقاله “الاستياء من الديمقراطية في الشرق الأوسط”، في محاولة لتفسير انقلاب قيس سعيّد: “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الناس في الشرق الأوسط مختلفون عن بقية البشر في تفضيل الحرية وسيادة القانون على الديكتاتورية. لكن العقد الماضي أظهر أيضاً سذاجة أولئك الذين كانوا يأملون في أن تترسخ الديمقراطية بسهولة في جميع أنحاء المنطقة. وبدلاً من ذلك، أكدت الأحداث مدى صعوبة قيام انتخابات حرّة بتأسيس حكومات مستقرّة في البلدان التي حالت فيها عقود من الديكتاتورية دون ظهور المؤسسات الأخرى التي تجعل الديمقراطيات تعمل: المحاكم المستقلة، ووسائل الإعلام الحرّة، والخدمة المدنية المهنية، والسكان المتعلمون (في وقت الثورة المصرية، كان حوالي 26 % من السكان أميين)”. ويخلص الكاتب إلى أنّ “تجارب الديمقراطية فشلت في حل مشكلات الشرق الأوسط، ولكن من غير المرجّح أن تكون الاستبداد المتجدد أكثر فعالية”.
لسنا الصين، لا توجد نجاحات اقتصادية للدول العربية تبرّر غياب الديمقراطية. الاستبداد في بلادنا يراكم فشلاً اقتصادياً وتنموياً وسياسياً، ولا فرصة أمام الشباب غير الهجرة في ظل انسداد الأفق أمامهم، وفي “فورين بوليسي” نشر مقال عن لبنان، لكنه يصلح للتعميم عربياً، مع فارق في النسب فقط. من المقال: “يقول الخبراء إن الطفرة الحالية في هجرة الأدمغة سيكون لها تأثير دائم على بلدٍ يعاني من أزمات لا تعد ولا تحصى. سوف يؤدي هروب رأس المال البشري إلى تفاقم انهيار الاقتصاد المنهك بالفعل ويعيق انتعاشه. ولكن مستويات اليأس مرتفعة للغاية، إلى درجة أن 77% من الشباب اللبناني يرغبون في الخروج، بحسب أحد الاستطلاعات. في الواقع، في العالم العربي، يأتي الشباب اللبناني على رأس قائمة الذين يرغبون في الهروب من بلدهم، متقدمين على 54% من معاصريهم في سورية المنكوبة بالحرب، و58% من الشباب الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بعض التقديرات، غادر 20% من الأطباء اللبنانيين، أو يخططون للمغادرة، منذ الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد عام 2019. وأغلقت مئات الصيدليات أبوابها، ما جعل الصيادلة عاطلين. يتواصل النزوح الجماعي المستمر لموظفي الرعاية الصحية، مثل الممرّضات. وقد اجتذبت دول الخليج المئات منهم. قالت ريتا حويك، اختصاصية العلاج الطبيعي، إنّ مستشفاها في طرابلس شهد عشرات الاستقالات، ذهبوا إلى السعودية وقطر وكندا. وفي أي مكان عليهم إرسال الأموال إلى ذويهم في الوطن”. ويضيف المقال “يقال إن نصف دزينة من المهندسين يبحثون عن خطابات توصية من رؤسائهم يومياً للتقدم لوظائف خارج البلاد. وأكثر من 1500 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الأميركية في بيروت التي تضم المركز الطبي في الكلية، انسحبوا على مدار العامين الماضيين، وفقاً لتقرير صادر عن معهد الشؤون العالمية الحالية. وتعمل شارلوت كرم، وهي أستاذة مشاركة في الجامعة، على تمكين المرأة في المنطقة، وهي من هؤلاء. وتقول إن 40% من زملائها قد استقالوا، وإن الأرقام سترتفع هذا العام. قضايا شخصية ومهنية ومالية عديدة أثارتها الأزمة الاقتصادية جعلتها تغادر لبنان، على الرغم من حبها له”.
… تجربة لبنان قابلة للتعميم، يحبون أوطانهم، لكنهم لا يقدرون على البقاء فيها. وهذا استثناء عربي على مستوى العالم.
العربي الجديد
————————-
إعادة هندسة دستور 2014: هل يمكن أن تكون مخرجًا لأزمة الحكم في تونس؟
نظَّم مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر ندوة بحثية عن بُعد يوم الثلاثاء، 10 أغسطس/آب 2021، لمناقشة الظروف والأوضاع التي تعيشها تونس بعد اتخاذ رئيس البلاد قرارات يوم 25 يوليو/تموز الفائت تقضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه وحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وتولي مهام النائب العام، وما رافق ذلك من انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض ومواقف إقليمية ودولية أيدت وعارضت وأخرى تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع.
وقد استضافت الندوة ثلاثة باحثين تونسيين مختصين في السياسة والقانون، هم: رابح الخرايفي، وعبد الرزاق المختار، وأحمد إدريس، وباحثًا مصريًّا مختصًّا أيضًا في السياسة هو عصام عبد الشافي، وأدارت الندوة المذيعة بقناة الجزيرة مباشر، وعد زكريا.
وناقش المتحدثون ثلاثة محاور أساسية، الأول: عن الأسباب الداخلية التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع المتأزم، والثاني: عن دور العامليْن، الإقليمي والدولي، فيما حدث وما سيحدث، والثالث: عن آفاق الحل وطبيعته. وقد اختلفت زوايا النظر لما حدث بين متحدث وآخر كما اختلفت التوقعات التي يمكن أن تذهب إليها تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس على النحو التالي:
تعديلات دستورية منتظرة
يرى الباحث في القانون الدستوري والنيابي، رابح الخرايفي، أن الرئيس التونسي، قيس سعيِّد، يتَّبع في سياسته العامة وإدارته شؤون البلاد أسلوب المفاجأة والغموض وبالتالي لا يستطيع المراقب توقع ما سيحدث غدًا، وقال: إن الذي نعلمه فقط أننا نعيش في إطارين استثنائيين؛ الأول وفق الفصل 80 من الدستور، والثاني وفق إجراءات الطوارئ التي أعلنها الرئيس يوم 25 يوليو/تموز الفائت، وهما أمران استثنائيان يخالفان السير العادي لمؤسسات الدولة، وإنَّ هذا الغموض وتلك المفاجآت يتنافيان مع مطالبات قسم من التونسيين بضرورة وجود خارطة طريق تحدد وتوضح خطوات السير في الحاضر والمستقبل. ويؤيد الخرايفي تلك القرارات التي أقدم عليها الرئيس باعتبارها في رأيه ضرورة بعد أن وصلت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع إلى درجة لم يكن مجديًا التعامل معها بغير تلك الطريقة التي انتهجها الرئيس.
وبشأن المخاوف المثارة على الديمقراطية التونسية من جرَّاء تلك القرارات يعتقد الخرايفي أنها مبالغ فيها وأن التجربة الديمقراطية التونسية بخير ولن تضار مستقبلًا.
كما يرى الخرايفي أن الحديث عن دور إقليمي أو دولي دفع الرئيس قيس سعيِّد لاتخاذ تلك القرارات هو حديث أيضًا غير دقيق، بدليل -وفق ما قال- أن الدول الإقليمية والدولية فوجئت بما حدث وتراوحت مواقفها بين مؤيد ومعارض وواقف على الحياد.
وعن الجذور العميقة للأزمة الحالية، يعتقد الخرايفي أنها تعود إلى طبيعة النظام السياسي الذي تأسس في تونس بعد الثورة والذي يوزِّع السلط التنفيذية بطريقة غير حكيمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن المرحلة القادمة -بحسب تقديره- سوف تشهد إقدام رئيس الجمهورية على إدخال تعديلات على دستور 2014 خاصة في باب السلطة التنفيذية بحيث تكون اختصاصات وصلاحيات رئيس الحكومة بيد الرئيس، مع توافر مزيد ضمانات ومزيد صلاحيات للبرلمان حتى لا يتحول الرئيس إلى ديكتاتور، وقال الخرايفي: إن هذه هي الجرعة الثانية التي ألمح إليها الرئيس في اليوم الوطني للتلقيح ضد وباء كورونا يوم 8 أغسطس/آب الجاري.
الحل “الاستراتيجي” المنشود
هذه كانت رؤية رابح الخرايفي لأسباب الأزمة ومسارها، أما عبد الرزاق المختار، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية فله قراءة تتفق مع القراءة السابقة في جزء منها وتختلف في أجزاء أخرى. فهو يتفق على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس وصلت قبل قرارات الرئيس قيس سعيِّد إلى حالة مزرية، غير أنه يرى أن الرئيس “استثمر” تلك الحالة واتخذ القرارات سابقة الذكر والتي جعلت البلاد تعيش مناخ أزمة عميقة تتمثل تجلياتها في العطالة الكلية أو الجزئية لمؤسسات الدولة، وقد بات الجميع في حالة من محدودية الفعل والتأثير، بما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل، انتظارًا للفاعل الوحيد في المشهد وهو رئيس الجمهورية. بل إنَّ ثمة غيابًا نسبيًّا -يضيف المختار- للجدل العام بشأن الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد مما يجعلها لا تحظى بأولوية مجتمعية في الوقت الراهن.
كما اتفق عبد الرزاق المختار أيضًا في توصيف الشق الدستوري المتعلق بالأزمة الحالية مع ما قاله الخرايفي قائلًا: إنَّ تونس مضت في طريق أخذت فيه بخلطة جمعت فيها بين النظامين، البرلماني والرئاسي، مع توزيع غير متكافئ للسلطات والصلاحيات نصَّ عليها الدستور انطلاقًا من شرعيات لم تكن متماثلة؛ فالرئيس منتخب انتخابًا عامًّا ومباشرًا بينما أعضاء البرلمان منتخبون انتخابًا نسبيًّا، مما خلق صراعًا حول الشرعيات. ويوضح المختار وجهة نظره بقوله: إنه قد قام التصور الدستوري على فكرة تعاون السلط مع بعض تعاونًا غير مشروط، وهو ما لم يكن موجودًا لاعتبارات هيكلية وسياسية؛ الأمر الذي جعل النظام السياسي مولِّدًا للأزمات.
والعنصر الثاني الذي تسبب في الأزمة العميقة التي تعيشها تونس حاليًّا، وفق قراءة عبد الرزاق المختار، هي ما أطلق عليه “السبب البنيوي”، ويقصد به الحالة الحزبية والثقافة السياسية السائدة في البلاد، فالحالة الحزبية في رأيه لا تزال هشة وغير مكتملة الأركان، وإن الموجود منها في تونس ليست أحزابًا بالمعنى الغربي للأحزاب بقدر ما هي “ظاهرة حزبية” محكومة في تصرفاتها الراهنة بالعقلية التي كانت عليها قبل الثورة؛ عقلية رد الفعل على الاستبداد، ورد الفعل على تحديات الانتقال الديمقراطي.. “إن الأحزاب التونسية خلال السنوات العشرة الماضية لم تكن متشبعة بالقيم البرلمانية وهو ما جعلها في حالة عجز حيال الحكم”.
أما السبب الذي وصفه بـ”السياقي” فمتعلق في رأيه بالانتقال الديمقراطي، وهنا يقول المختار: نحن نتحدث عن تونس وكأنها ديمقراطية مستقرة والحال أنها ديمقراطية ناشئة، وإنَّ الانتقال الديمقراطي أمواجه متلاطمة ومتعارضة وهو ما يولِّد في العادة حالة من السيولة المؤسساتية على مستوى الأحزاب الشائخة وعلى مستوى الدولة المرتخية، وهذا كله كان من الأسباب التي غذَّت موضوعيًّا أزمة الحكم التي كان لها -كما ذكرتُ- أبعادها الدستورية والبنيوية.
ولا يرى عبد الرزاق المختار، أستاذ القانون الدستوري، في المحكمة الدستورية التي لم تر النور بعد مخرجًا نهائيًّا لأزمة النظام السياسي التونسي، فإن موضوع المحكمة الدستورية في تقديره إنما هو إجراء “تكتيكي” وليس حلًّا “استراتيجيًّا”، والحل الاستراتيجي الذي يتصوره هو في “إعادة هندسة دستور 2014 والبقاء داخله”.
الشرعية الشعبية مقابل الشرعية الدستورية
لم يبتعد كثيرًا أحمد إدريس، المدير التنفيذي لمركز الدراسات المتوسطية والدولية عمَّا قاله المختار في مداخلته السابقة، غير أنه لم يكن متفائلًا فيما يتعلق بإمكانية حل الأزمة التونسية في القريب، وفي هذا السياق يقول: نحن الآن في وضعية مؤلمة ونفق مظلم ولا نرى النور قريبًا، لأن ما دخلنا فيه يوم 25 يوليو/تموز أدخلنا في وضعية مجهولة لا نعلم مآلها بعد. ويضيف: يأمل البعض في العودة إلى الشرعية الدستورية والسياسية سريعًا، لكن ما نعيشه اليوم من ضبابية يجعلنا نقول: إنَّ من الصعوبة أن يكون هذا الأمل قريبًا.
وعن توصيفه للوضع التونسي الراهن على وجه التحديد، أوضح أحمد إدريس أن العقد الاجتماعي الذي تم التوافق حوله في دستور 2014 قد انفصم، وأن المجتمع وصل بانقسامه إلى حافة الحرب الأهلية، وأوضح أن التشنج الذي كان موجودًا في الشارع يوم 25 يوليو/تموز قد يعمِّق الأزمة ولا يجعل لها أفقًا، وأن هذه الحالة عمومًا تحول دون تقارب أطراف الأزمة من أجل وضع تصور للحل أو إطار لعقد اجتماعي جديد.
وبشأن تصوره للعقد الجديد إن تم، قال إدريس إنه سيكون انفراديًّا وأحاديًّا، وسوف تُغلَّبُ فيه الفكرة الأحادية التي يدافع عنها رئيس الجمهورية، والتي عبَّر عنها في حديثه الهاتفي مع الرئيس الفرنسي مؤخرًا حينما حدَّثه عن “الشرعية الشعبية مقارنة بالشرعية الدستورية”. وهذا يدل، من وجهة نظره، على أن هنالك استعدادًا للتخلي بشكل نهائي عن دستور 2014 والخوض في تجربة دستورية جديدة، أو سياسية جديدة لا تكون بالضرورة دستورية وإنما عن طريق مساهمة جزء من الشعب أو الشارع في صياغتها.. وكل هذا “يجعل النفق الحالي طويلًا جدًّا ومظلمًا، ويجعل الأمل في العودة إلى الحالة العادية بعيدًا جدًّا”، خاصة أن جزءًا من الرأي العام يدفع رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات صارمة كوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ومحاسبة من يعتبرونهم فاسدين أو مفسدين سياسيين، وربما الإقدام على حل بعض الأحزاب والجمعيات.. وإن الفكرة تختمر الآن في رأس رئيس الجمهورية -يقول إدريس- ولا نعلم ما سيفاجئنا به، لقد قال أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح خلال اليوم الوطني للتلقيح صراحة: إن هنالك جرعة ثانية (يقصد من الإجراءات الاستثنائية) ما يعني أنه يهدد بجرعة ثانية ضد “كل الأدران العالقة في الحياة السياسية في تونس”، معنى ذلك -والكلام لإدريس- أنه مُقدِم على إجراءات أخرى سوف تقلب الحياة السياسية التونسية رأسًا على عقب، وهذا لن يخرجنا من عنق الزجاجة.
وأكد إدريس على أن من يدفعون رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات صعبة يرون في ذلك فرصة أمامهم للتخلص من بعض المنافسين السياسيين لهم ولكن لا يعلمون كذلك أنهم يدفعون برئاسة الجمهورية إلى خوض تجربة قد تكون قريبة جدًّا من الديكتاتورية رغم تصريحه في مناسبات عديدة بأنه لا مجال للعودة إلى الديكتاتورية لكنه قد يجد نفسه مدفوعًا إلى اتخاذ قرارات تعتبر من الإجراءات التعسفية.
وعن رؤيته لدور المجتمع المدني من غير الأحزاب في حلحلة الأزمة التونسية الراهنة، لا يعتقد إدريس أنه سينجح في ذلك هذه المرة كما نجح عام 2013، وفي هذا الصدد يقول: سوف يكون من الصعب أن تلعب منظمات المجتمع المدني، والفاعلون من غير الأحزاب السياسية، أي دور في حلحلة الأزمة، لأن الأحزاب هي منظمات تمثيلية وسيطة بين المجتمع والسلطة، وأنَّ الطرف القوي اليوم الماسك بالأمر والنهي وهو رئيس الجمهورية لا يؤمن بهذا الدور الوسيط للمنظمات الموجودة في المجتمع، وبالتالي فإن عدم الإيمان هذا يخلق جزءًا من الأزمة، لأنه لا يمكن حلحلة الأزمة إلا إذا قبلنا بالوساطات وهو ما نراه اليوم صعبًا جدًّا رغم ما رأيناه في اليوم الثاني للقرارات الاستثنائية من اجتماع الرئيس بممثلين عن المجتمع المدني، لكن هذا اللقاء -يضيف إدريس- كان بغرض طمأنتهم على الوضع وليس بغرض حلحلة الأزمة، وإنَّ الرئيس لم يطلب من هذه المنظمات القيام بأي دور، ورأينا بعدها أن أهم هذه المنظمات -وهو الاتحاد العام التونسي للشغل- عمل على وضع خارطة، وعرض على رئيس الجمهورية أن يكون هناك نوع من التعاون للخروج من الأزمة لكن الرئيس أطال الوقت ولم يأخذ بمقترحه وبالتالي أسهم في تعميق الأزمة. وعليه، فلا نرى اليوم أن الاتحاد يقوم بنفس التجربة التي حدثت في عام 2013، وإنما بات ينتظر قرارات الرئيس. إنَّ ما نعيشه اليوم هو أن الرئيس قد لا يلجأ إلى هذه المنظمات لأنه سار في موقفه وقراراته وسوف يعمل على تنفيذها والمضي فيها إلى أبعد الأشواط، وربما تكون القطيعة هذه المرة بين السلطة والمنظمات الوسيطة المتمثلة في منظمات المجتمع المدني.
وقال إدريس في مداخلته: ربما إذا كان لا يزال ثمة دور للمجتمع المدني فإنه يتمثل في ضغطه على رئيس الجمهورية حتى لا نخرج من إطار الشرعية الدستورية، ولا نخرج من دائرة دولة القانون في مواجهة الأزمة، وأشار إلى أن الرئيس ربما يكون قد حقق الآن انتصارات سريعة على خصومه كما هي الحال في مشهد اليوم الوطني للتلقيح، لكن -والكلام لإدريس- كيف سيكون التصرف حينما تأتي أيام أخرى يكون الرئيس مطالبًا فيها باتخاذ قرارات يحتاج فيها إلى دعم لكي يطبقها في الشارع؟ إنه في هذه الحالة سيحتاج إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي لا يوليها الآن اعتبارًا.
وعمَّا إن كان أفق للحوار والتوافق السياسي في تونس يُخرج البلاد من أزمتها الراهنة، قال إدريس: إنَّ الحوار هذه المرة قد لا يكون مخرجًا، لأن طريقة رئيس الدولة في التعامل مع الأحزاب والمجتمع المدنية “طريقة أحادية”، كأنه لا يستمع إلى آراء الآخرين، ولا يذهب إلَّا إلى النهج الذي يحدده لنفسه، وقد ظل لمدة طويلة بنفس الفردية ونفس الخطاب ونفس المفردات وكأنه يُهيِّئ لشيء ما وأن قراراته تسير في هذا الاتجاه.
وأوضح إدريس بعدًا آخر يعزز به رأيه فيما يتعلق باستبعاد الحوار كأداة مجدية لحلحلة الأزمة التونسية الراهنة؛ إذ قال: إنَّ الحوار قد لا يكون مجديًا مع الأحزاب الحالية لأن النظام السياسي الذي قد يرغب فيه رئيس الجمهورية قد لا يكون هو ذاته الذي ترغب فيه تلك الأحزاب، فمثلًا الحديث عن “الديمقراطية القاعدية كبديل للديمقراطية التمثيلية” هو حديث مرفوض من كل الأحزاب والفاعلين السياسيين ما عدا رئيس الدولة، فالأمر عنده إذًا ليس فقط تغييرًا في النظام السياسي من نظام برلماني إلى رئاسي وإنما “تغيير في المنظومة الديمقراطية بأكملها لتنطلق من الأسفل مضيًّا إلى الأعلى”، وهذه الفكرة ليست واضحة في فكر من يتعاونون مع رئيس الدولة كما أنها ليست واضحة في ذهن معارضيه، خاصة وأن الرئيس لم يعبِّر عنها بشكل منهجي ولم يقدِّم خريطة طريق لتحقيقها ولا تصورًا نظريًّا في كيفية تحقيق ذلك، وبالتالي -يختم إدريس- هي مجرد استنتاجات من قبل محلِّلين؛ الأمر الذي يجعل المناخ الحالي مناخًا “غير توافقي” على الأقل، لاسيما أن هذا التوافق قد أصبح مرفوضًا في ذهن الكثيرين.. “ولا أدري في نهاية المطاف ما هو البديل إذا لم نذهب إلى التوافق”.
تبديد الأوهام
وهكذا دارت نقاشات الندوة بين الباحثين التونسيين الثلاث؛ فمنهم من هو مطمئن على المسار الديمقراطي ويهوِّن من الإجراءات التي اتخذها الرئيس، ومن هو متشائم ويرى صعوبة بالغة في الخروج مما وصفه بالنفق المظلم، ومنهم من يرى الأمور بين هذا وذاك.. أما الباحث المصري، عصام عبد الشافي، مدير المعهد المصري للدراسات ومقرُّه تركيا، فإنه يرى أن ما يحدث في تونس هو أمر مخطَّط من قبل الدول الإقليمية والدولية الراغبة في إفشال ثورات الربيع العربي والتي قادت الثورة المضادة في مصر وليبيا وسوريا واليمن والسودان بأدوات مختلفة لكن لتحقيق ذات الهدف وهو وقف مسار التحول الديمقراطي وإبقاء هذه المنطقة عبر الاستبداد في حالة من التبعية.
وعدَّد عبد الشافي أوجه التشابه بين ما يحدث في تونس وما حدث في مصر وتبرير البعض إجراءات الرئيس التونسي بأنها رغبة مجتمعية، وقال في هذا الصدد: إنَّ شبكات التواصل الاجتماعي ليست معيارًا لقياس شعبية قرارات رئيس الجمهورية، لأنه يمكن التحكم بها، بل في كثير من الأحيان يتم توجيهها من قبل جهات بعينها، وإنَّ عدم وجود فعاليات شعبية رافضة لقرارات الرئيس التونسي ليست دليلًا على الرضا عن تلك القرارات.. فهذا معيار غير دقيق، لأنها (الفعاليات الشعبية غير الموجودة حاليًّا) قد تكون تعبيرًا عن حالة من الغضب المكتوم، كما أن ثمة حالة من “الزهد الشعبي” في العملية السياسية بأكملها، وبالتالي هي حالة من الغضب العام تعبِّر عن نفسها بعدم الرغبة في المشاركة بأية فعاليات، لأنه في النهاية -والكلام لعبد الشافي- أصبحت الشعوب العربية على قناعة بأنها لا أهمية ولا دور لها في إحداث التغيير، وقد وصلت إلى هذه القناعة بسبب آلات القمع التي مورست ضدها.
وعلَّق عصام عبد الشافي على ما وصفه أحمد إدريس في مداخلته السابقة حينما قال: إن فكرة المزيد من الإجراءات الاستثنائية “في طور التخمر” بعقل الرئيس، قائلًا: إنَّ الأمر واضح ومحدد وإن الإجراءات واضحة ومحددة.. قد تكون لتونس خصوصيتها السياسية كما للسودان والمملكة المغربية ومصر لكن، ومع مراعاة هذه الخصوصيات، فإنَّ هناك “مطبخًا واحدًا يدير عملية الثورة المضادة في العالم العربي”؛ هذا المطبخ يتفق على الإجراءات والسياسات ويترك تنفيذها للوقت المناسب في كل بلد من بلدان الربيع العربي، سواء كانت هذه الإجراءات انقلابات عسكرية كما حدث في الحالة المصرية والسودانية، أو انقلابات سياسية تحت المسمى الدستوري كما حدث في الحالة التونسية. وبالتالي -والكلام لا يزال لعبد الشافي- فنحن لدينا منذ 2011 ما يسمى بحلف الثورة المضادة، وإنَّ أطرافه واضحة معروفة، وإن بعض الممارسات التي شهدتها تونس، على سبيل المثال، حينما هوجمت مقرات حركة النهضة وقع ما يشبهها تمامًا بمهاجمة مقرات جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013.
وبشأن المستهدف تحديدًا من محاولات تعطيل المسار الديمقراطي وما إن كانت هي جماعات الإسلام السياسي كما يعتقد البعض، قال عبد الشافي: إنَّ المستهدف الحقيقي ليس حركات الإسلام السياسي لكن، وفي كل الانقلابات العسكرية والسياسية، هو التجربة الديمقراطية في العالم العربي.. فالفزَّاعة التي تُستخدم هي الحركات الإسلامية، لكن الحلف المضاد للثورة يعنيه في المقام الأول والأخير ألَّا تكون هناك بأية حالة من الحالات إرادة سياسية للشعوب العربية، أو سعي لها من أجل الحرية والديمقراطية، وإن هذا الحلف يقوم بدعم النظم التسلطية لتحقيق أهدافه.
واتفق عصام عبد الشافي مع ما قاله أحمد إدريس بشأن تحقيق الرئيس انتصارات سريعة وأنه لن يستمر في تحقيقها مستقبلًا حينما يصطدم بالواقع، وفي هذا الصدد، قال: إن التجربة المصرية تثبت ذلك بالفعل؛ فقد راهن النظام المصري على بعض المشروعات، كالعاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء الكباري والجسور، لكن هناك قضايا ومشكلات حقيقية لم يستطع التعامل معها وتسببت في زيادة معدلات الفقر وتردي الخدمات وارتفاع الدَّيْن العام.
وعن دور وتأثير العامل الخارجي في الحالة التونسية الراهنة، قال عبد الشافي: إن العامل الإقليمي والدولي هو الأكثر تأثيرًا في كل التحولات التي شهدتها الدول العربية، والمقصود به هنا -يوضح عبد الشافي- هو بعض الأطراف الدولية التي تحرك أطرافًا إقليمية للعبث بالمسار الديمقراطي والتحول السياسي في هذه الدول.. وهنا اختلف مع قراءة رابح الخرايفي حينما تحدث عن أن المساعدات الدولية فيما يتعلق بلقاحات كورونا دليل على أن هناك دعمًا لهذا المسار، وأن المواقف الدولية قد تغيرت وأصبحت أكثر حيادية.. وقال عبد الشافي: إن المواقف الدولية لم تتغير؛ فقد كانت ابتداء داعمةً لما اتُّخذ من قرارات استثنائية ليس يوم 25 يوليو/تموز فحسب بل وقبل ذلك حينما زار قيس سعيِّد القاهرة في شهر مايو/أيار الماضي، وكذلك حينما زار فرنسا، واتضحت أكثر بزيارة وزير الخارجية الإماراتي لتونس خلال الأيام الماضية.
واختتم عصام عبد الشافي مداخلته بالحديث عمَّا أسماه الحاجة إلى “تبديد الأوهام وتجنُّب خلط المفاهيم”، وعدَّد جملةً منها قائلًا: من ذلك أنه لا خوف على الديمقراطية في تونس. والحقيقة أن ثمة خوفًا حقيقيًّا على الديمقراطية التونسية، لأن هناك انقلابًا متكامل الأركان بوابته الرئيسية هي الانقلاب على الدستور والمؤسسات القائمة وترسيخ الاستبداد بيد رئيس الجمهورية الذي أصبح يتحكم في كل مفردات العملية السياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
الوهم الثاني الذي يجب تبديده -وفق عبد الشافي- هو الحديث عمَّا يسمى بالجمهورية الثالثة، فالحديث عن الجمهوريات ليس بهذه السهولة، وليس بمرور أيام وأسابيع أو سنوات، فالجمهوريات تحتاج إلى فلسفة نظام، وإلى بنية تشريعية لهذا النظام، وتحتاج أيضًا إلى وضوح رؤية في توجهات النظام ومؤسساته، فضلًا عن ضرورة وجود أجيال جديدة تؤمن بالديمقراطية الحقيقية التي ترسَّخت.
الوهم الثالث الذي يرى عبد الشافي ضرورةً لتبديده يتمثل في السؤال التالي: هل النظام الرئاسي أفضل أم النظام البرلماني؟ ويقول في هذا الصدد: من وجهة نظري ليست المشكلة في أن يكون هذا أو ذاك أو خليطًا من هذا وذاك؛ فلدينا نماذج من نظم سياسية مختلفة الأشكال ومع ذلك تعاني من إشكاليات، وإنَّ النقطة الجوهرية هنا هي في طبيعة العلاقة بين السلطات والضوابط التي تضمن وتضبط وترسِّخ الفصل بين هذه السلطات وعدم هيمنة أية سلطة على الأخرى أو على مسارات هذه العملية السياسية بأكملها.
واختتم عصام عبد الشافي مداخلته ومن ثم اختتمت الندوة أعمالها بقوله: أقول للتونسيين، بمنتهى الأمانة: لستم في حاجة إلى انتظار ثماني سنوات لتصلوا إلى ما وصلت إليه مصر من أجل تقييم المسار الحالي؛ فلديكم شواهد مباشرة حولكم، والمؤشرات تدفع للقول: إنَّ هناك تشابهًا، إن لم يكن توافقًا، بين ما آلت إليه الأوضاع في مصر مع ما ستؤول إليه الأوضاع في السودان وما ستؤول إليه الأوضاع في تونس خلال فترة زمنية قليلة.
—————————–
=====================
تحديث 13 آب 2021
——————————
هكذا يغيّر قيس سعيّد قواعد اللعبة/ صلاح الدين الجورشي
لا تزال الأوضاع مستقرة في تونس بعد مرور نحو أسبوعين على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد. هل يعني هذا أن البلاد انتقلت فعلياً إلى مرحلة جديدة مختلفة عن سابقتها؟ وهل أن ما حدث قد طوى نهائياً تجربة الانتقال الديمقراطي المتعثر حسب ما يأمله الكثيرون داخل تونس وخارجها؟ وهل ألقت حركة “النهضة” المنديل الأبيض، وانكمشت على حالها في انتظار ما قد تحمله الأيام والأسابيع المقبلة من أخبار سيئة لقادتها وقواعدها؟
يبدو أن سعيّد غير متعجل الخطى، حيث لم يعين بعد رئيساً جديداً للحكومة، على الرغم من الدعوات التي وجهت له في هذا الشأن من الداخل والخارج. يتركز نشاطه على الاهتمام بمشاغل المواطنين الصحية وغلاء الأسعار، واحتكار المواد الأساسية، وملاحقة المتهمين بالفساد. فهو يتابع بارتياح الحملة المنظمة والناجحة إلى حد ما لتلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين ضد فيروس كورونا. فكمية اللقاحات التي وصلت تكفي لتأمين أكثر من 40 في المائة من المواطنين. فالرئيس يريد من وراء ذلك أن يكسب أوراقاً وازنة لكي يعزز مكانته، ويواصل عزل خصومه، شعبياً وسياسياً.
في هذا السياق لوحظ أن الخط التحريري لمعظم وسائل الإعلام، خصوصاً العمومية منها، قد تغير لصالح رئاسة الجمهورية. أصبحت تصريحات الرئيس ونشاطاته تحتل المرتبة الأولى في نشرات الأخبار. كما تعزز عدد المؤيدين للرئاسة من مختلف المواقع والفئات الاجتماعية، وذلك في مقابل تراجع الاهتمام بنشاط الأحزاب، وانخفاض أصواتها، خصوصاً تلك المعارضة لسعيّد.
من جهة أخرى، تتواصل عمليات إقالة مسؤولين في مواقع متعددة أمنية وإدارية، مقابل تعيينات جديدة لوجوه أخرى سيتم الاعتماد عليها لتنفيذ سياسات رئيس الدولة، إلى جانب إحالة البعض على القضاء ومنع آخرين من السفر. ويبدو أن هذه السياسة الأمنية مرشحة لتطول، من حيث الزمن والعدد، على الرغم من ردود فعل المنظمات الحقوقية. فالبلاد تتجه تدريجياً نحو التخلص من منظومة، بكل مكوناتها ورموزها ومرجعياتها، واستبدالها بأخرى لم يتضح بعد الكثير من معالمها وآلياتها.
قيس سعيد
أصبح من المؤكد أن صفحة ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي قد طويت. هذا ما تؤكده عديد المؤشرات، من أهمها ما جاء على لسان سعيّد نفسه في تصريحات عديدة. وعلى هذا الأساس لن يفتح البرلمان أبوابه من جديد نهاية أغسطس/آب الحالي كما يتوهم البعض، بل قد يذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك، فيصدر قراراً مؤقتاً للسلطات العمومية، قد يليه العمل على صياغة دستور جديد يلغي بمقتضاه دستور 2014، ويفتح الباب أمام ما يسميه بعض السياسيين بـ”الجمهورية الثالثة”، مقارنة بما فعله الجنرال الفرنسي الراحل شارل ديغول.
هذا المسار من شأنه أن يضع الأحزاب السياسية، من دون استثناء، أمام نظام سياسي معادٍ لها. فالرئيس لم يكتف بوضع حركة “النهضة” في زاوية حادة وصندوق مغلق، بل تجاهل بقية التنظيمات، إذ لم يستقبل أيا منها، ولم يستشرها في أي خطوة ينوي القيام بها، بما في ذلك حركة “الشعب” القريبة منه، أو حزب “التيار الديمقراطي” الذي سانده، وسبق لبعض قادته أن شجعوه على اللجوء إلى اتخاذ قرارات استثنائية تغير جذرياً الخريطة السياسية. وعلى الرغم من أن هذه الأطراف الحزبية بدأت تشعر بالمأزق، وأخذت تحذر من الانزلاق نحو الحكم الفردي أو إلغاء منظومة الأحزاب برمتها، ومن ذلك ما جاء على لسان القيادي في “التيار” وزير التربية السابق محمد الحامدي من أن “الدعوات التي تسعى إلى تبخيس الأحزاب والمنظمات جربت مراراً ولم تثمر إلا الاستبداد”، إلا أن هذه الأصوات أصبحت غير مسموعة مثلما كان من قبل، وهو ما جعل خصومها يهاجمونها، ويعتبرون أنها أدت دورها بنجاح في تيسير تنفيذ الخطة التي استقرت في ذهن سعيّد.
مع ذلك، يتساءل البعض: كيف سيتصرف الرئيس التونسي مع الوعود التي قطعها أمام الجميع، عندما أعلن أنها ليست ضد الحريات والديمقراطية، وأنه ملتزم بالمهلة الزمنية لتجاوز حالة الاستثناء؟ ما تجدر الإشارة إليه أن سعيّد ليس معزولاً، فهو يستند في تحركه الحالي إلى مساندة المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن جهة أخرى يقف إلى جانبه جزء واسع من الرأي العام المحلي. هذا ما يردده الرئيس لجميع المسؤولين الأجانب، الذين اتصلوا به خلال الأيام الماضية. وهو حالياً بصدد كسب المعركة الدبلوماسية التي تحاول “النهضة” استعمالها ضده، لإظهاره على أنه يقود انقلاباً على الديمقراطية. سلاح يبدو أنه بصدد التهاوي نظراً إلى اعتماد الحكومات الغربية، في الملفات الشبيهة، على مدى قدرة الفريق الذي يمسك بدواليب الدولة على ضمان الاستقرار، وحماية مصالح هذه الأطراف، وتجنب ارتكاب انتهاكات فظيعة في مجال حقوق الإنسان.
يمكن القول إن سعيّد كسب الجولة الأولى، وأن خصومه، وتحديداً “النهضة”، لم يعد أمامهم هامش كبير لإحراجه أو منافسته ميدانياً. لقد أسدل الستار على المرحلة السابقة، ودخلت المنظومة الحزبية في أزمة حادة لا يعلم أحد إن كانت قد انتهت بسببها، أو أنها ستبقى في قسم الإنعاش لفترة أخرى قد تطول. صحيح أن هناك انتهاكات وقعت وتقع هذه الأيام، وأن هناك أصواتاً عديدة، حقوقية وغيرها، ترتفع حالياً وتنادي بعدم إصلاح خطأ بأخطاء أكثر فداحة، لكن ذلك وحده غير كافٍ للحيلولة دون إيقاف المنعرج الجديد.
العربي الجديد
——————————–
هل تصل “مرونة النهضة” إلى حد استقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان؟/ وليد التليلي
أعلنت حركة النهضة التونسية في بيان، أمس الخميس، أنها “ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريباً، ويسهم في إعداد البلاد لانتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية”.
وأضاف البيان أن “حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية؛ مستعدة للتفاعل الإيجابي مجدداً من أجل استكمال المسار الديمقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معاني الوطنية. وأينما تكُن مصلحة تونس تكُن النهضة”.
وشكّل البيان تحولاً كبيراً في موقف الحركة من تطورات المشهد في تونس، وكان لافتاً التشديد في البيان على “مرونة الحركة في ما يتعلق بالبرلمان” والتذكير بـ”التخلي عن الحكم كما حصل في 2013 بعد الحوار الوطني”، وقال قيادي من الحركة لـ”العربي الجديد” إن النهضة تعني كل كلمة في البيان ومستعدة لكل التنازلات من أجل إنقاذ تونس وديمقراطيتها، وحول سؤال إن كان ذلك يعني أيضاً إمكانية استقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان؛ رد القيادي بالإيجاب، مرجحاً أن ذلك مطروح أيضاً إذا كان سيقود لتفاهمات حقيقية تعيد سير المؤسسات الدستورية، ولكن هذا لم يطرح في مؤسسات الحركة بعد، وليس أمام الحركة ولا بقية مكونات المشهد خارطة واضحة البنود للمناقشة.
ويؤكد بيان النهضة أنها مستعدة لبحث كل الصيغ الممكنة، ولكن الخط الأحمر كما أوضحه البيان هو “المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور ثورة 14″، وهي منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. وقد وفّرت الديمقراطية من الطرق السلمية ما هي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها”.
وبقرار من مجلس الشورى في دورته الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة؛ أُعلن عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني. وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت. وهي لجنة مؤقتة، تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
محمد قوماني- حركة النهضة
وستتكوّن هذه اللجنة من وجوه شابة في أغلبها، ومعروفة بانفتاحها على الساحة وعلاقاتها مع مختلف مكوناتها، ويبدو أنها ستمنح صلاحيات مهمة في التفاوض، فيما يتساءل متابعون عن ردود الفعل التي ستقابلها اللجنة من داخل النهضة نفسها، وسط خلافات لم تعد خافية على أحد.
ويشكل البيان منعطفاً مهماً في تعامل النهضة مع قرارات 25 يوليو/تموز، (لم تسمها انقلاباً) رغم أنه لم يكن مفاجئاً في العمق. وللتذكير فقد كان المستشار الخاص لحركة النهضة، سامي الطريقي، قد نقل عن رئيسها، راشد الغنوشي، قوله: “يجب أن تصبح إجراءات 25 يوليو/تموز فرصة للإصلاح ومرحلة من مراحل المسار الديمقراطي”.
وقال الطريقي لـ”العربي الجديد” ليلة انعقاد مجلس الشورى يوم 4 أغسطس/آب الماضي، إن الغنوشي قال في افتتاح المجلس: “كان علينا عدم مواصلة دعم حكومة فشلت في إدارة الأزمة، والرئيس تحمّل مسؤوليته ولكن يجب استرجاع الوضع الطبيعي والعودة إلى المؤسسات الدستورية”، مشدداً على أنه “لا يجب أن نفوّت على الشعب التونسي الأمل في التغيير”.
وقال الطريقي إن الغنوشي دعا “الجميع إلى الانخراط في جهد الدولة، وقال: “نطالب الرئيس بتشكيل حكومة سريعاً والنهضة غير معنية بها، ونحن مع عودة البرلمان مع الاتفاق على طرق جديدة للعمل”، وشدد الغنوشي على أنه “لن نسمح بانطفاء شمعة تونس، ولن نسمح لأحد بزرع الفتنة، وسوف نفتح حواراً مباشراً مع الرئيس”.
ويؤكد البيان أغلب هذه النقاط المذكورة، وتبقى معرفة كيف ستتفاعل الساحة السياسية التونسية مع هذا الموقف، وخصوصاً كيف سينظر الرئيس سعيّد لهذا الموضوع، وهو الذي شدّد أمس الخميس على “ألّا عودة إلى الوراء مطلقاً”.
العربي الجديد
———————————-
وفد أميركي رفيع المستوى في تونس ولقاء مرتقب مع قيس سعيّد
وصل وفد أميركي رفيع المستوى
، اليوم الجمعة، إلى تونس لإجراء لقاءات مهمة مع مسؤولين محليين، بحسب ما أكد مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ”العربي الجديد.
ورجح المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن يتم الإعلان عن تفاصيل زيارة الوفد الأميركي، مساء اليوم الجمعة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت إذاعة “موزاييك” التونسية كشفت، أمس الخميس، عن زيارة وفد أميركي رفيع المستوى تونس، يضم كلا من نائب وزير الخارجية الأميركي بالنيابة جوي هود ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت بالأبيض جوناتان فاينر ومدير مكتب شمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوش هارس.
رجّحت مصادر لموقع “موزاييك” التونسي إمكانية لقاء الوفد الأميركي الرئيس قيس سعيّد.
ويتساءل مراقبون عن أهداف وخلفية هذه الزيارة، خصوصاً مع تزايد القلق الأميركي على الديمقراطية التونسية، وفق ما كشفته المواقف الأميركية المتواترة بشأن تونس، عقب قرارات سعيّد الأخيرة.
في 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، الأمر الذي وصفه محللون وسياسيون بـ”الانقلاب”.
ردود أميركية على قرارات سعيّد
وبعد ساعات على قرارات سعيد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال الإيجاز اليومي: “نحن قلقون بشأن الوضع في تونس”.
وأضافت: “نتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع”.
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز إنه “قلق جداً حيال التقارير الآتية من تونس”.
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أي بعد يومين من قرارات سعيّد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد وحثه على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف المتحدث في بيان أن بلينكن “حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف”.
وكان بيان للخارجية الأميركية أفاد بأن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس”، مضيفاً “كنا على اتصال بمسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.
وتابع البيان: “لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام، ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.
وشدد على أنه “يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية”.
وفي الـ30 من الشهر الماضي، أصدر رئيس مجلس الإدارة ديفيد برايس ونائب الرئيس فيرن بوكانان، من حزب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، بياناً مشتركاً حول الوضع في تونس، أكدا فيه أن “الأحداث في تونس، الديمقراطية البرلمانية الوحيدة التي ظهرت من الربيع العربي، تبعث على القلق الكبير”.
وجاء في البيان المشترك أنه “بينما يستمر العالم في النضال بقوة مع فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الناتجة عنه، فإن تعليق المؤسسات الديمقراطية والبرلمان المنتخب حسب الأصول في تونس ليس هو الحل أبداً”.
وأشار البيان إلى أن “الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في تونس تتعارض مع روح الديمقراطية وممارستها، وتقوض المقومات الأساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس”، داعياً السلطات التونسية إلى حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية، والسماح لأعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطياً بالعودة إلى العمل، واتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قضاء قوي ومستقل، واحترام حرية الصحافة”.
وفي 31 يوليو/تموز، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي، في اتصال هاتفي، على وضع خطة للعودة السريعة إلى المسار الديمقراطي في بلاده.
وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشاً مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيّد.
ونقل المسؤول الأميركي دعم الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.
ولفت إلى أن: “الدعوة ركزت على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي”.
وشدد على أن “هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة، بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب”.
وقال: “بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على أهبة الاستعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي”.
وفي 3 أغسطس/آب الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس أخيراً “انقلاباً”، إن الوضع هناك “زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعاً إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي”.
وأضاف المتحدث أنه “في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي”.
وفي 5 أغسطس، أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي بوب منينديز ونائبه الجمهوري جيم ريش بياناً مشتركاً حول تونس، أعربا من خلاله عن “قلق عميق من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس”.
وقالا إنه يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد “إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأميركية التونسية”. وأكدا أنه “تجب على الجيش التونسي مراقبة دوره في الديمقراطية الدستورية”.
وجاء في البيان المشترك أن “الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تنامت وتعمقت، لأنها تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية”.
العربي الجديد
——————————
===================
تحديث 15 آب 2021
————————-
تونس في انتظار رئيس وزراء.. ضغوط شعبية ودولية لإعلان خارطة الطريق/ حسين قايد
بعد أكثر من 20 يوما على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المفاجئة بإقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، لم يعلن عن تعيين رئيس وزراء جديد، ولا زال هو من يدير شؤون البلاد، لكن إلى متى؟
توقع مراقبون أن يعلن سعيد عن خطته الشاملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، يوم الجمعة الماضي، تزامنا مع العيد الـ65 للمرأة التونسية، لكن هذا لم يحدث.
رغم حصول قرارات سعيد على تأييد الكثير من التونسيين إلا أنها أثارت قلق المراقبين بشأن مسار الديمقراطية والحرية في البلاد، وخاصة أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على هذا المسار بعد ثورات الربيع العربي.
يقول إبراهيم أومنصور، محلل شمال أفريقيا في المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية، في تصريحات لموقع “صوت أميركا”: “السؤال هو: ماذا سيفعل سعيد الآن؟”. وأضاف: “هل سيواصل فعلاً الإصلاحات الكبيرة التي وعد بها التونسيين، وسيبقي على هذه السلطات الجديدة في يده مؤقتًا للتعامل مع الأزمة؟ أم سيبقيها على المدى الطويل؟”.
مطلب دولي وشعبي
يرى الباحث السياسي، خالد عبيد، أن القضية مسألة وقت، مؤكدا أنه لا يمكن للرئيس احتكار كل السلطات في يده.
وأضاف عبيد في تصريحات لموقع “الحرة” أن سعيد سيعلن عن ذلك عندما يرتب الأمور وفق مصلحته ويتيقن أن الأمور استقرت، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك قبل نهاية شهر أغسطس حتي لا يتعرض لضغوط من المجتمع المدني التونسي.
بينما يقول المحلل السياسي، الصغير الذكراوي، إن الإعلان لن يتأخر طويلا؛ لأن الرئيس لم يعد لديه خيار التأخير في الإعلان.
وأضاف الذكراوي في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه قد يتم الإعلان خلال أسبوع عن رئيس الحكومة على الأقل، ثم يتم الإعلان بعد ذلك عن باقي المسارات السياسية للمرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن الإعلان عن رئيس الحكومة أصبح مطلب تونسي بالأساس قبل أن يكون مطلب دولي، مؤكدا على حاجة البلاد لحكومة تكون مسؤولة خلال هذه الفترة أمام الرئيس والشعب.
كان سعيد أعلن في 25 يوليو، إعمال بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، لمدة شهر قابلة للتجديد. وألمح سعيد إمكانية تمديد قرار تجميد عمل البرلمان.
جاءت قرارت سعيد بعد نحو 5 أشهر من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب بشأن التعديل الحكومي بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.
وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
رسالة بايدن
أما عن دستورية إعلان الرئيس تشكيل الحكومة بمفرده دون وجود البرلمان، يرى عبيد أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية فإن الدستور التونسي يتيح للرئيس التونسي تأويل الدستور وفق رؤيته وهو ما اعتمد عليه في قرارات 25 يوليو.
وأوضح أنه وفق المادة 80 يتيح الدستور للرئيس اتخاذ التدابير الاستثنائية في حالة الخطر الداهم، وبالتالي سيكون قادرا علي تشكيل الحكومة بمفرده.
خلال الأيام الماضية، زار وفد أميركي تونس للقاء سعيّد، وضم كل من النائب الأول لمستشار الأمن القومي، جوناثان فاينر، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود.
وخلال اللقاء، ناقش فاينر سعيّد بشأن الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلّف، بهدف تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجه تونس.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إيميلي هورن، في بيان إن تمكين حكومة جديدة لخلق استقرار في الاقتصاد سينتج مساحة أيضا لحوار شامل بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة، استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في تونس لتحسين مستويات المعيشة والحكم بشفافية وصدق وفعالية.
كما بعث الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة لسعيد مع الوفد الأميركي، أكد فيها على دعمه الشخصي ودعم الإدارة الأميركية للشعب التونسي، وحث على “العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس”.
ويعتقد عبيد أن “رسالة بايدن تؤكد أنه لا يوجد رفض أميركي لهذه القرارات وأنها تعطيه الثقة، لكن تطالب بخطوات لإثبات حسن النية تحافظ على المسار الديمقراطي في البلاد وتحترم حقوق الإنسان”.
وأوضح أن هناك توجه ورغبة في تغير نظام الحكم إلى نظام رئاسي ديمقراطي بدلا من نظام ديمقراطي، ويتم استفتاء الشعب على ذلك، ثم إجراء انتخابات تشريعية لتشكيل البرلمان.
“خطوات أكثر صرامة”
وقالت منظمة أبحاث مجموعة الأزمات الدولية إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بحاجة إلى “اتخاذ خطوط أكثر صرامة، حتى لو كانت وراء الكواليس”، لإلزام سعيد بخريطة طريق مفصلة بحلول أكتوبر لإعادة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، بحسب موقع “صوت أميركا”.
ويقترح آخرون ربط تلقي تونس للمساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو الآن قيد التفاوض، بالالتزام بعلامات الديمقراطية مثل سيادة القانون والمساءلة.
ومع ذلك، أشار المحلل أومنصور إلى أن المخاوف الغربية بشأن الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم العربي تفوق تقليديًا الخطاب المؤيد للديمقراطية.
ووفقا لبيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، فقد ذكّر سعيّد خلال لقائه الوفد الأميركي بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.
وحذّر الرئيس التونسي من “محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس”، معتبرا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي.”
وقال سعيد إنه “تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها”، مؤكّدا على أن تونس “ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين”.
كان سعيد رفض دعوات حركة النهضة المتكررة بالحوار، وقال إنه لا حوار مع من وصفهم “بخلايا سرطانية”
وأرجع عبيد رفض سعيد للحوار لأن حركة النهضة كانت تسعى من خلاله إلى الحفاظ على موضوع قدم في الخارطة السياسية التونسية، وأضاف أن “الحوار كان مشروط بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو وهذا ما يرفضه الرئيس والشعب”.
وقال عبيد: “تونس بعد 25 يوليو غير تونس قبل هذا 25 يوليو، المنظومة انتهت وهذا البرلمان لن يعود”.
حسين قايد – دبي
—————————-
=================
تحديث 17 آب 2021
———————–
تونس ما بعد 25 تموز: قيس سعيد..وإغواء النظام الرئاسي
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
بعد مرور ثلاثة أسابيع على انقلابه على الدستور، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءاته الهادفة إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، والتي بدأها ليلة 25 تموز/ يوليو 2021، وقام خلالها بعزل رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، ورئاسة النيابة العامة، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وتثير الإجراءات المتتالية التي يتخذها الرئيس، في ظل غياب الحكومة والبرلمان ومحكمة دستورية عليا، تخوفات كبيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة، ومستقبل المسار الديمقراطي في تونس، ومصير الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي.
فراغ مؤسساتي
أعلن الرئيس قيس سعيد أن “الإجراءات الاستثنائية” التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو 2021 ستتلوها إجراءات فورية؛ أهمها تسمية رئيس جديد للحكومة يعمل تحت إشراف رئيس الدولة. وعلى الرغم من انقضاء ثلاثة أسابيع لم يعين سعيد، حتى الآن، رئيسًا جديدًا للحكومة، بل تصرف كأنه رئيس الحكومة أيضًا؛ فقد أصدر أوامر رئاسية، غير مسبوقة، بتسمية مكلفين بتسيير وزارات الداخلية والصحة والعدل؛ إذ من المفترض أن تسبق تسمية رئيس الحكومة تسمية أعضاء فريقه الحكومي. ورغم وصف الأعضاء الجدد بـ “المكلفين بتسيير الوزارات”، وهي صفة تطلق، عادة، على الوزراء المباشرين الذين يكلفون بتسيير وزارات أخرى إضافة إلى وزاراتهم الأصلية في حال حصول شغور طارئ، ولمدة محدودة إلى حين تكليف وزراء جدد، فقد دُعي هؤلاء “المكلفون بتسيير الوزارات” إلى أداء اليمين، في خطوة عدّها بعض الخبراء الدستوريين تجاوزًا آخر للدستور في مادته الـ 89 التي تنص على أن اليمين الدستورية يؤديها رئيس الحكومة وأعضاؤها (الوزراء وكتّاب الدولة) لا “المكلفون بتسيير الوزارات”.
ويشير التأخير الحاصل في تسمية رئيس الحكومة وفريقه إلى الصعوبات التي تعترض سعيد في اختيار شخصية تقبل تولي المنصب في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي صعب، وتكتفي بدور رئيس وزراء لدى رئيس يعلن، صراحة، نيته الهيمنة على كل السلطات. ويضاعف غياب خريطة طريق واضحة للخروج من المأزق السياسي الراهن من تداعيات الفراغ الإداري والحكومي؛ حيث تشهد مختلف الوزارات والقطاعات حالة ترقب وعطالة، خاصة بعد عزل عدد من الولاة، والظهور المتكرر للرئيس وهو يؤنب بطريقة استعراضية المسؤولين ويحملهم وزر المصاعب التي تمر بها البلاد، ويتهمهم بالفساد و”التنكيل بالشعب”، ويطالبهم بمراعاة ظروف المواطنين وتخفيض أسعار المواد التموينية والأدوية وخدمات الكهرباء والماء والمستلزمات المدرسية ونسب الفائدة البنكية، من دون أن يطرح – وقد غدا صاحب السلطة الرئيس في البلد – سياسات أو حلولًا عملية وواقعية تأخذ في الاعتبار التشريعات المعمول بها، وحسابات التكلفة والإنتاج ومعادلات السوق وأسعار الصرف ورصيد البلاد من العملات الصعبة وأبواب ميزانية الدولة وحال العجز التي تمر بها جلّ المؤسسات العامة.
يضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف التزامات الدولة التونسية تجاه المقرضين والمانحين الدوليين، في ظل حاجة الموازنة العامة إلى توفير 6.7 مليارات دولار (18.6 مليار دينار تونسي بأسعار الصرف الحالية) لمعالجة العجز المسجل فيها، علاوة على 5.6 مليارات دولار لخدمة الدين، بينها 3.6 مليارات دولار بالنقد الأجنبي، وضرورة الاستعداد لجولات جديدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مقابل الالتزام بتنفيذ وصفة من الإصلاحات الاقتصادية؛ نذكر منها الرفع التدريجي للدعم على السلع التموينية والمحروقات والكهرباء والماء وتخفيض كتلة الأجور بالقطاع العام، وسط تحذيرات من خفض تصنيف تونس الائتماني مجددًا.
ويبدو أن الرئيس يعوّل، وفق ما أعلنه بنفسه، على وعود دول خليجية بضخ مساعدات مالية في الاقتصاد التونسي للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن هذه الوعود لم تثمر حتى الآن أي التزامات فعلية. وقد بينت التجربة أن الدعم الاقتصادي في مثل هذه الحالات من بعض دول الخليج يخضع لأجندات سياسية متعلقة برفض النموذج الديمقراطي في المنطقة العربية.
مكافحة الفساد: وعود في انتظار التنفيذ
دأب الرئيس سعيد، قبل 25 تموز/ يوليو وبعده، على استهداف من يصفهم بـ “الفاسدين” و”اللصوص” و”مصاصي دماء الشعب”، وهي عبارة عن تشهير عام لا يجوز أن يلقيه رئيس دولة جزافًا. فمكان محاربة الفساد هو المحاكم، وليس الخطابات الحماسية. ولكن هذا القدح والذم المتواصل يأتي في إطار خطاب شعبوي هدفه استمالة الجماهير الغاضبة وتحضيرها نفسيًا لكي تتقبل قمع الخصوم السياسيين، وربما النظام البرلماني عمومًا. وقد استندت معظم مبرراته للإجراءات التي اتخذها إلى رغبته في “تفكيك منظومة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورفع الغطاء عنهم”؛ بمن فيهم مسؤولون حكوميون وقضاة ورجال أعمال وأعضاء في البرلمان. وحال إعلان سعيد عزل رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ومنح نفسه صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية مطلقة، امتلأت صفحات تواصل اجتماعي مؤيدة لإجراءاته بمزاعم عن حملات اعتقال ودهم واسعة استهدفت مشتبهين بالفساد، ليتبين، فيما بعد، أن جلّها مثل التهم التشهيرية التي سبقتها، شائعات لا أساس لها، وأن الاعتقالات التي لحقت أعضاء في البرلمان استهدفت شخصيات كانت معروفة أصلًا بمعارضتها للرئيس سعيد، وتمت على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي (مثل النائب ياسين العياري المعروف بمثابرته في محاربة الفساد) أو بناء على شكايات رفعتها جهات أمنية (نواب ائتلاف الكرامة)، ولا علاقة لها بالحرب على الفساد.
وقد أفاد عدد من القضاة أن الجهات الأمنية منعت بعضهم من مغادرة البلاد وعطلت سفر آخرين، على الرغم من عدم وجود قرارات رسمية مكتوبة بهذا الشأن؛ ما أثار جدلًا حول قانونية هذا الإجراء الذي استهدف قطاعًا بأكمله، ومنع بموجبه القضاة، باعتبارهم مواطنين، من حقهم الدستوري في حرية الحركة والتنقل. ويزيد هذا من الخشية والتوجس لدى السلطة القضائية من دوافع هذه الإجراءات؛ إذ سبق لمجلس القضاء العدلي أن رفض قرار سعيد تولي رئاسة النيابة العامة، في حين أصدر 45 قاضيًا ومستشارًا بيانًا نددوا فيه بما وصفوه بـ “الإجراءات التعسفية” و”التعدي على سلطات القضاء والمحاكم”.
وفي السياق ذاته، لم تسجل، حتى الآن، أي ملاحقات تذكر، على علاقة بملفات فساد في صفوف المسؤولين الذين دأب الرئيس على توجيه الاتهامات إليهم. وقد وضع وزير الاتصالات الأسبق، القيادي في حركة النهضة، أنور معروف قيد الإقامة الجبرية من دون الإفصاح عن أسباب اتخاذ هذا الإجراء غير القانوني في تونس، في حين تبين أن إيقاف 14 من المسؤولين السابقين المشتبه في صلتهم بملفات فساد في “شركة فسفاط قفصة”، والذي روّج له في صفحات مقربة من الرئيس على أنه جرى بأوامر رئاسية، قد تم بناء على شكاية تقدم بها النائب السابق رئيس “مرصد رقابة” لمكافحة الفساد، عماد الدائمي، منذ أشهر، ولا علاقة له بالإجراءات الرئاسية الأخيرة.
الحريات وحقوق الإنسان: تعهدات تنتظر الوفاء بها
على الرغم من أن الرئيس سعيد، دأب منذ 25 تموز/ يوليو، على تأكيد حرصه على حماية الحقوق والحريات العامة، فإن منظمات حقوقية أشارت إلى تجاوزات وأعمال تضييق شملت مدونين ووسائل إعلام؛ إذ أودع أكثر من مدون السجن على خلفية نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعت فرق صحافية من العمل، وأغلقت مكاتب قنوات فضائية، وأعفي مسؤولون إعلاميون من مهماتهم، بينهم المدير العام للتلفزيون الرسمي. وقد لوحظ تغيّر في الخط التحريري للتلفزيون الحكومي والقنوات الخاصة، على حد سواء، بتخصيص مساحات واسعة من نشرات الأخبار والبرامج الحوارية لتغطية نشاطات الرئيس والإشادة بها كما هو سائد في الدول العربية السلطوية؛ ما يوحي بأنها تجري بتعليمات واضحة في هذا الاتجاه. ولوحظ أيضًا غياب شبه تام لرأي معارضي إجراءات الرئيس في المنابر الإعلامية المختلفة. وكان الرئيس سعيد وجّه، في وقت سابق، انتقادات إلى وسائل الإعلام على ما اعتبره تقصيرًا في منح نشاطاته أولوية في التغطية والمتابعة. وفي السياق ذاته، نبهت نقابة الصحافيين التونسيين إلى جملة من التجاوزات التي لحقت الفرق الصحافية، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وشملت اعتداءات بالعنف والضرب مارستها الشرطة، والمنع من العمل، وإغلاق مكاتب بعض المؤسسات الإعلامية من دون الاستناد إلى تكليف قضائي، داعية رئاسة الجمهورية إلى “احترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومة الدقيقة في حينها”، وإلى إلزام رجال الأمن بـ “قواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي”.
اتجاهات الأزمة واحتمالاتها
بعد مرور ثلاثة أسابيع على إجراءات 25 تموز/ يوليو، ما زال الرئيس، الذي منح نفسه صلاحيات شبه مطلقة، لم يفصح بعد، عن أي خريطة طريق للمرحلة المقبلة، على الرغم من المطالبات الداخلية والخارجية المنادية بسرعة الخروج من الوضع الاستثنائي والعودة إلى المسار الدستوري. وتذهب معظم المؤشرات إلى أن الرئيس سعيد ماضٍ في مسعاه الرامي إلى طي صفحة السنوات العشر التي تلت ثورة 2011، من خلال تركيز جميع السلطات بين يديه، وإضعاف دور البرلمان والأحزاب والنقابات والسيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية. ويستعين الرئيس في توجهه هذا بالإحباط العام السائد من أداء القوى السياسية، خلال السنوات الأخيرة، ومن تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، فضلًا عن ارتباك المعارضة وتشتتها وضعف أدائها والصراعات الداخلية التي تتفاقم داخل بعضها، على غرار حركة النهضة التي شهد موقفها مما حدث تذبذبًا بدءًا بوصفه بـ “الانقلاب”، وانتهى بالتراجع عن ذلك، والتعامل معه على أنه أمر واقع واجتهاد سياسي لمواجهة الواقع الصعب الذي تمر به البلاد، مع رسائل غير مباشرة تعد بحركة نقد ذاتي، وكأنها تتفق مع تقييم الرئيس في تحميلها الجزء الأكبر من المسؤولية عما حصل؛ ما يهدد وحدة الحركة وتماسك صفوفها.
لم يتبق أمام الرئيس سوى أسبوع واحد لتبديد الغموض بشأن مصير البرلمان الذي جمدت صلاحياته لمدة شهر تنتهي في 24 آب/ أغسطس 2021. وعلى الرغم من قصر الحيز الزمني المتبقي، ما زال الرئيس يلتزم الصمت بهذا الشأن، باستثناء تأكيده المتكرر على أن الأمور “لن تعود إلى الوراء”. إذا عاد البرلمان إلى العمل مع نهاية فترة التجميد، كما في السابق، وفق السلطات التي يخولها له الدستور، فسيمثل ذلك فشلًا لمشروع الرئيس الذي كرس حيزًا مهمًا منه للحط من قيمة البرلمان والديمقراطية التمثيلية برمتها. من جهة أخرى، لن يكون سهلًا على الرئيس إبقاء الحياة السياسية معطلة إلى ما لا نهاية، مع تنامي الضغوط الخارجية التي تطالبه بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وتشكيك داخلي في شرعية أي حكومة لم تنل ثقة البرلمان وفي أي تشريعات صادرة عن الرئيس في شكل مراسيم وأوامر رئاسية.
خاتمة
من المحتمل أن يسعى الرئيس خلال الفترة المقبلة إلى محاولة تغيير القانون الانتخابي، وتعديل الدستور بهدف التحول إلى نظام حكم رئاسي، وانتخاب المحكمة الدستورية بالصيغة التي يراها. ومع أن البعض يهيئ للرئيس أن الظروف مؤاتية لتمرير هذه التغييرات في ظل تعطيل البرلمان، والانقسامات بين القوى السياسية، والمزاج الشعبي الرافض للتجاذبات التي شهدها البرلمان طوال السنتين الأخيرتين، فإن ذلك قد يمثل قفزة في المجهول، خاصة أن الرئيس لا يعطي أي إشارات توحي بأنه يمتلك برنامجًا إصلاحيًا واضحًا أو رؤية تسمح بإخراج البلد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي الأزمات التي اتخذها ذريعة للانقلاب على الدستور.
يحاول الرئيس حاليًا جمع الحلفاء وتفريق الخصوم، لكي يحرف المسار الديمقراطي في اتجاه نظام رئاسي لا يلبث أن يتحول إلى سلطوي؛ فهو لا يؤمن بالديمقراطية. ولا شك في أن لهذا الخيار حلفاء، ولكن ثمة نخبًا تونسية واسعة معارضة له، وثمة شعب اعتاد على الحرية. وسوف يحاول الرئيس ومن يدعمه مقايضة الحريات بحل الأزمة الاقتصادية. وهذه أيضًا مسألة غير مضمونة، وباختصار هذا صراع لم يحسم بعد.
المدن
—————————–
تدويل الواقعة التونسية/ المهدي مبروك
مرّ نحو ثلاثة أسابيع على تونس، منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد، عن قرارات استثنائية، رأى فيها عديدون انقلابا على الدستور، في حين رآها آخرون خرقا للدستور فرضته حالة الشلل التي أصابت أجهزة الدولة ومؤسسات الحكم، علاوة على الحالة الوبائية الخطيرة في سياقٍ تشهد فيه البلاد منذ أكثر من عقد أزمة اقتصادية واجتماعية. لن يعود الكاتب هنا إلى تحديد المسؤوليات التي يتقاسمها الجميع، وبدرجات متفاوتة، فالرئيس سعيّد مثلا يتحمّل قسطا من المسؤولية، وهو الذي رفض أداء يمين الوزراء وختم قانون المحكمة الدستورية. وربما كان تعفين الوضع ودفع البلاد إلى مزيدٍ من التأزيم إحدى استراتيجياته لتأجيج الغضب، والاستناد إلى شرعية ما، سرعان ما أصبحت في خطابه وخطاب أنصاره شرعية “الإرادة الشعبية” وهي التي تمكّنه من تجاوز المسؤوليات والاستحواذ على السلطات، التنفيذية والقضائية والتشريعية، فالرئيس يحكم بأمره منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تولى خلالها تعيين الولاة والمكلفين بتسيير الوزارات، وأحال مشتبها فيهم عديدين على المحاكم، وأجبر آخرين على الإقامة الجبرية التي لا يجيزها الدستور التونسي مطلقا، واعتبرتها المحكمة الإدارية مرّات عدة باطلة.
وسط ذهول بعضهم وحذر آخرين، يواصل أنصار سعيد حشد مزيد من التعاطف، ففي أقل من أسبوعين، تشكلت أجسام “شبحية”: تنسيقيات، جيل الرقميات، المجلس الأعلى للشباب، وأخيرا الحشد الشعبي، وكلها أجسام لا تخضع إلى أي تصنيف قانوني، فهي ليست منظمات أو جمعيات. ويُخشى أن تتحول إلى أجسام سياسية لها اليد العليا في ظل عدم إيمان الرئيس بالأحزاب مطلقا، واعتبارها تحايلا على المواطنين. وباستثناء بعض التوقيفات تحت لافتة مقاومة الفساد، لم يوضح الرئيس أي خريطة للطريق، بعد ان تنقضي مدة هذه الإجراءات التي وعد أنها تنتهي بعد ثلاثين يوما، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحا لتمديد هذه المدة. وقد ارتفعت أصوات المخاوف بشكل واضح من منظمات وطنية عديدة، ومن المجتمع المدني، في بياناتٍ عدة رأت في الهجوم على القضاة والتحرّش بالإعلام والمنظمات الوطنية، على غرار الفلاحين، بوادر عودة الاستبداد مجدّدا.
في هذا المناخ المتوتر، والذي يُخشى أن يعيد تونس إلى مربع التسلط، توافد على تونس عشرات المسؤولين. ولافت للانتباه أن أول هؤلاء قدموا تباعا من السعودية والإمارات ثم مصر، من مستويات رفيعة، ما يؤكد أهمية الرسائل التي حملوها إلى الرئيس سعيد. تُضاف إلى ذلك مواقف الدول الأوروبية التي يرتبط الاقتصاد التونسي بها ارتباطا وثيقا. وقد صدرت تلك المواقف عن فرنسا وألمانيا وغيرهما، وعن الاتحاد الأوروبي الذي عبّر عن انشغاله بتطورات الوضع التونسي، وظلّ متردّدا حسب ما ورد في بيانه، غير أنه لم ير في ما قام به الرئيس انقلابا، متعهدا بأنه سيدرس توصيف ما حدث لاحقا. وعموما، ظلت أغلب المواقف “خجولة”. مع ذلك، أجمعت على ضرورة العودة سريعا عن تلك الإجراءات الاستثنائية، واستئناف المسار الديمقراطي، على عثراته وعلاته .
وجاء الاهتمام الأميركي بالواقعة التونسية استثنائيا، فقد استقبل الرئيس سعيد يوم 13 أغسطس/ آب الجاري، وفدا رفيع المستوى فيه مكونان أساسيان، أمني ودبلوماسي، نقل رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن. وقد صدر عن البيت الأبيض، إثر ذلك بيان (الخامس من 25 يوليو/ تموز)، حث فيه الرئيس على ضرورة التمسّك بالديمقراطية البرلمانية، وتعيين رئيس حكومة في أقرب الأوقات، لتتفرّغ لمجابهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، وضرورة إجراء حوار وطني إدماجي، من أجل رسم الإصلاحات الدستورية، وإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات فئات واسعة من التونسيين. ولكن بيان رئاسة الجمهورية جاء مخالفا تماما لما أورده البيت الأبيض، فضلا عن تصريحات عديدة مقرّبة من دوائر الرئيس، ترذل “الاستقواء بالأجنبي”، وهذه من سرديات نظام بن علي المهجورة. وقد بدأت رائحة التخوين تلاحق كل من تسوّل له نفسه انتظار الضغط الخارجي، مطالبين الرئيس بـ”الصمود أمام الضغوط الخارجية”، والانتصار للقرار الوطني وحتمية الذهاب إلى أقصى ما يمكن أن يرد في خيال هؤلاء، حتى ولو كانت تلك الفرضيات تنسف الحد الأدنى من ثوابت الانتقال الديمقراطي.
يتم إعلاء السيادة الوطنية خارج تنظيرات العلاقات الدولية وتشابك المصالح، وتعولم القضايا السياسية، متحصنين بمفهوم سيادوي تكرّسه عادة، وبشكل جوهري، الأنظمة الشمولية التي تنكّل بحقوق الإنسان تحت هذه اللافتة.
بعيدا عن هذه المقاربة، يدعو مثقفون وفاعلون سياسيون الى أهمية العودة إلى الحوار الوطني من أجل إعادة القطار التونسي إلى سكة الديمقراطية وبدء سلسلة مراجعات ذاتية، سواء في أوساط من حكموا أو عارضوا خلال العشرية المنصرمة، وهي التي من شأنها أن ترسّخ المسار الديمقراطي، وتلجم أي نوازع للاستبداد، يبرّر لها بعضهم عادة تحت مسوّغات عددية، منها الإرادة الشعبية.
سيبدو من المستبعد أن يأخذ الرئيس التونسي بما نصحه به الوفد الأميركي. والأرجح أن يذهب في تطبيق ما أعلنه مرارا “لا للعودة إلى الوراء” متوعّدا خصومه الذين نعتهم، في أكثر من موقف، بالفيروسات والجراثيم السياسية، بأنه سيتم تطهير البلاد منهم، فمكانتهم التي تليق بهم، كما قال، هي قنوات الصرف الصحي، وهذه مفردات تنتمي إلى قاموس لم يعتد عليه الفرقاء السياسيون حتى في زمن بن علي.
العربي الجديد
————————
المسؤولية الديمقراطية والمسؤولية عنها/ عبد الوهاب الأفندي
طرح الانقلاب الكاريكاتوري، سيّئ الطبخ والإخراج والقيادة، على الديمقراطية التونسية، أسئلة مهمة بشأن طبيعة المسؤولية السياسية في الإطار الديمقراطي، وكذلك المسؤولية عن حماية الديمقراطية، وهما أمران متداخلان. فالقيادات المنتخبة ديمقراطياً عليها مسؤولياتٌ كجزء من مهام الحكم، وأهمها العمل بجدّية على تنفيذ البرامج التي انتُخبت على أساسها، والوفاء بحدّ أدنى من مسؤوليات الدولة. فالسياسي ينتخب لكي يؤدّي مهام محدّدة، ثم يحاسب عليها، ويستبدل من لم يفِ بها ليأتي غيره. في الوقت نفسه، ينعكس سلوك القادة المنتخبين وأداؤهم سلباً وإيجاباً على رؤية الشعب للعملية الديمقراطية، وقد يقوّض الثقة فيها إذا تدنّى مستواه، فالقيادة المنتخبة ديمقراطياً مسؤولة في الديمقراطية، ومسؤولة عنها.
ويرتبط هذا بما تعجّب منه معلقون كثر مما بدا أنه ترحيب قطاع كبير من التونسيين، بين العامّة والنخبة، بالانقلاب وتهليلهم له، بل حتى ما وصفه المهدي مبروك بـ “كراهية الديمقراطية”. مثل هذه الكراهية لا تنتج من تطوّرات سياسية وقتية، بل تمثل قناعات. وإذا استبعدنا ما دأب بعضهم على ترداده أن العرب/ المسلمين لا يعقلون الديمقراطية ولا يطلبونها بسبب “معوقات ثقافية”، فلا بد من التساؤل عن سرّ رفض خصوم التجربة التونسية العملية الديمقراطية برمتها، خصوصاً إذا صحّت مزاعمهم بأنّ طرفاً واحداً، هو حزب النهضة (لم يحصل على أغلبية أصلاً) هو المشكلة، فلماذا لا يلجأون إلى الحل الديمقراطي السهل، ويدعون إلى انتخاباتٍ جديدةٍ تطيح “النهضة” وتأتي بمن يريده “الشعب”؟
يذكّرنا هذا بأنّ ما تشهده تونس اليوم هو، إلى حد كبير، تكرارٌ للتجربة المصرية التي وُئدت فيها الديمقراطية في مهدها، خصوصاً في ما يتعلق بأنّ السطو على مؤسسات الحكم الديمقراطية جرى في الحالين في وضح النهار، وليس في غسق الليل أو السحر، كما هي العادة. وفي الحالتين، جاء البغاة من داخل التجربة ومن تحت سقف الديمقراطية، وعبر مؤسساتها. وفي الحالين، كانوا يدّعون أنهم جاؤوا لاستحضار الديمقراطية الحقيقية، (ولكن من دون أن يفكروا أبداً في الانتخابات الحرة النزيهة، ولا متطلباتها الأخرى من إعلام حر وحريات، إلخ).
في الحالين أيضاً، يصبح الحديث عن “فشل الديمقراطية” موضوع تساؤل، فهل يمكن تسمية العدوان الوحشي على التجارب الديمقراطية من أعدائها فشلاً؟ ما تسمّى الديمقراطية في مصر بالكاد أكملت عاماً، ولم يكن للجهاز التنفيذي ولا التشريعي سلطان حقيقي فيها، فالرئيس لم تكن له ولاية على الجيش، ولا على الشرطة والأمن، ولا على القضاء، ولا على الجهاز البيروقراطي، ولا على الإعلام. فكيف يوصف بالفشل وهو لا يحكم، خصوصاً أن الجهات التي تحكم بالفعل هي التي قامت بالانقلاب؟ الأمر نفسه يمكن أن يقال في تونس التي أقال فيها الرئيس قيس سعيّد الحكومة التي وضعت تونس من أوائل الدول التي تغلّبت على وباء كوفيد 19 في 2020، إن لم تكن أولها، قبل أن يعرقل عمل الحكومة التي عيّنها بديلاً لها، ثم قام بالانقلاب عليها بحجّة أن الوباء عاد إلى التفشي، في عهده وعهدته، وكنتيجة مباشرة لتصرفاته؟
هذا بالطبع لا يعفي من الحديث عن المسؤولية الديمقراطية، وهو موضوع كان عزمي بشارة من أوائل من تصدّى له على صفحته في “فيسبوك” (28 يوليو/ تموز)، حيث تناول مساهمة أخطاء الأحزاب التونسية، وخصوصاً حزب النهضة، في توفير الذخيرة لأعداء الديمقراطية عبر المساومات غير المبدئية مع فلول النظام السابق، بدءاً بالتحالف مع الباجي قائد السبسي وحزب نداء تونس، على حساب العدالة الانتقالية، وانتهاءً بالتحالف مع نبيل القروي وحزبه “قلب تونس”، على حساب مكافحة الفساد. وما زاد الطين بلة، أنّ حركة النهضة تمادت في انتخابات 2019 في شيطنة القروي ووصفه بالفساد وكل نقيصة، داعمة بذلك منافسه قيس سعيّد، على الرغم من معاداة الأخير، الشعبوية السافرة، وكل مبدأ ديمقراطي. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن “النهضة” عادت وتحالفت مع القروي، فوضعت نفسها والديمقراطية في موضع الإدانة. وبحسب بشارة، أفقدت هذه المناورات الجمهور النماذج المبدئية للعمل الحزبي، مقابل ما يبدو أنها انتهازية فجّة، فشلت حتى هي في تحقيق هدفها البراغماتي. ذلك أن “النهضة” خسرت بهذه المناورات قطاعاً من جمهورها الأساس، المؤيد للديمقراطية والمتمرّد على الفساد، ولم تكسب جمهور الأحزاب التي تحالفت معها، وهي أحزابٌ تكره “النهضة” والديمقراطية معاً… هل نستنتج من هذا أنّ الديمقراطيات العربية الوليدة لم تتعرّض فقط للاغتيال والاختطاف، بل أيضاً انتحرت بممارسات القائمين عليها؟
هناك كثير من الصحة في هذا الاستنتاج، لأن العدوان على الديمقراطية لا يأتي في الغالب إلا بعد أن تكون قد قتلت معنوياً، عبر التأليب عليها، واستغلال التقصير الإداري، أو الأزمات الاقتصادية، أو الصراعات الأهلية، أو تفشّي “الفوضى” للتنفير منها، وتصوير الدكتاتورية حلاً. وفي حالاتٍ كثيرة، تستبق الأحزاب الأيديولوجية الأزمات، معلنةً رفض الديمقراطية من حيث المبدأ، مبشّرة ببدائل “ثورية” وصنوف من اليوتوبيا، يسعد فيها الشعب بنعيمٍ مقيمٍ تحت نظام طاهر مطهر، أو خالٍ من الطبقية، أو هو قاهر للاستعمار والمحتل الأجنبي .. إلخ.
ولكن هذا لا يخلي القوى الديمقراطية من المسؤولية، حتى لو قبلنا بأن ما وصفها الناقمون عيوب الديمقراطية من اجتراح هؤلاء المتربصين أنفسهم، كما أوضحنا، ومع الأخذ بالاعتبار التدخلات الأجنبية بتواطؤ مع القوى الأمنية والعسكرية في البلاد، فأخطاء الممارسة الديمقراطية تظل العامل الحاسم. والدليل سرعة سقوط التجربة المصرية في مقابل صمود التونسية، في ظل تشابه كثير (وتطابق) في التحدّيات، من هوية الجهات المتربصة، وأساليبها وتكتيكاتها.
الاحتجاج بأن خيارات الناخبين فاقمت المشكلة هو أيضاً لا يكفي. صحيحٌ أن الشعب المصري انتخب غلاة السلفيين للبرلمان، مفضّلاً إياهم على الأحزاب المعتدلة، بما فيها الإسلامية، ما عقّد مهمة قوى الاعتدال السياسي. بالقدر نفسه، الناخب التونسي هو الذي انتخب حزب نداء تونس ثم “قلب تونس”، ليضع فلول النظام السابق في البرلمان، ويفرض التعامل معهم لتسيير دواليب الحكم. وهذا بدوره نتج من عجز القوى “الديمقراطية” المعتدلة عن تعزيز وجودها البرلماني، وتحوّل بعضها إلى العداء للديمقراطية بسبب هذا العجز. إلا أن هذه أيضاً نقطة فيها قولان، حيث إن تحدّيات الديمقراطية معروفة، تحتاج إلى كثير من الحكمة والشجاعة، والمبدئية الأخلاقية، للتعامل معها، فالقوى المضادّة للديمقراطية لا تلام على اجتهادها في تقويضها، وإنما اللوم على أنصارها الذين لم يتحدوا لمعالجة المعضلات والتصدّي الخلاق لها. ويشمل ذلك تعزيز أهم ما يميز الديمقراطية، وهو آلياتها الداخلية للإصلاح والتغيير، فلا يكفي أن تتمكّن الجماهير من النقد إذا كانت آليات إسقاط الحكومة الفاشلة واستبدالها بغيرها غير فاعلة.
من هنا، لعل الخطأ الأكبر في حالة “النهضة” لم يكن التشبث بالسلطة كما يقال، بل بالعكس، تقديم تنازلاتٍ عنها في غير موضعها، والتخلي عن مسؤولياتها في الحكم، كأنها تعترف بأن وجودها في الحكم هو المشكلة. وهذا مضرٌّ بالديمقراطية كما التعصّب والتصلب، فالناخبون عندما يختارون حزباً يفعلون ذلك لبرنامجه. وقد اختيرت “النهضة”، وحلفاؤها الديمقراطيون، لأن هذه القوى مثلت نقيض النظام القديم، ولم تتلوّث بأجندته كغيرها. وكان هذا إشعاراً بأنّ المطلب هو القطيعة مع النظام القديم. في المقابل، كان انتخاب حزب نداء تونس في انتخابات 2014، من جهةٍ، اختياراً للاعتدال والوسطية، ومن جهة أخرى، بحثاً عن الخبرة العملية، وهو ما غاب في البرلمان الأول. ولا ينفي هذا أن قوى الثورة المضادّة ومناصريها الإقليميين موّلوا ذلك الحزب ودعموه إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً، وهللوا له، فيما بدا أنه كان “بروفة” للانقلاب.
ومن المهم أن يعقب الانتخاب تصدّي القادة المنتخبين للمسؤولية بجدّية وحزم، فإذا عجزوا عن ذلك، خصوصاً إذا كان ذلك بسبب تعويق المعوقين، فعليهم مصارحة الشعب باستحالة أداء المهمة، وتبرئة الذمّة من المسؤولية، وإتاحة الفرصة لقوى أخرى لتجرّب حظها. وإذا تطلب الأمر عقد تحالفاتٍ مع قوى سياسية أخرى، يمكن عقد صفقات، بشرط أن تكون مقبولة أخلاقياً، ومنسجمة مع المبادئ والبرنامج. ولا عيب في الديمقراطيات من المساومة، لأنها جزءٌ مهم من العملية الديمقراطية، على ألا تكون المساومات خنوعاً أو تواطؤاً في إجرام. وكنتُ قد قدّمت، في وقت سابق، تعريفاً للديمقراطية يتضمّن أن من أحد أركانها “المساومات القابلة للدفاع عنها أخلاقياً”، فالديمقراطية لا تقوم على التعصّب للمطلقات، حتى في ركنها الأساس المتمثل بالمساواة، ولكنها لا تقبل التأقلم مع كبائر المنكرات.
إذا لخصنا المشكلة نقول إن الشعب انتخب “النهضة” لتنفيذ برامجها وتوجهاتها، (وهي لم تكن برامج إسلامية، ولكنها إصلاحية ديمقراطية). وقد تنازلت “النهضة” عن المسؤولية الأساس تحت ضغوط هدّدت النظام الديمقراطي. وكان موقفها وقتها محلّ تقدير وإشادة من الغالبية (ومحل حقدٍ من الجهات التي أحفظها فشل جهودها لتقويض الديمقراطية). ولكنها لم تنقل المسؤولية إلى آخرين حتى يحاسبهم الشعب، ما أحدث إشكالين: أولهما أن الجهة الحاكمة بالفعل لم تكن تتحمّل المسؤولية، والثانية أن الناخبين حُرموا إحدى أهم ميزات الديمقراطية، وهي القدرة على تحديد المسؤول ومحاسبته، وبالتالي تغييره، فحركة النهضة لم تكن في الحكم ولم تكن خارجه.
أذكر أننا تناولنا في الحوارات التي كنا نرتبها سنوياً في مركز دراسات الديمقراطية بجامعة وستمنستر منذ نهايات التسعينيات حول الدور السياسي للحركات الإسلامية في المنطقة العربية (وكان يشارك فيها نفر من قادة هذه الحركات مع أكاديميين ودبلوماسيين غربيين)، إشكالية مماثلة في دور هذه الحركات في المعارضة، التي انخرطت فيها بما يكفي لمنح الأنظمة القمعية وأنصارها الفرصة لاستخدامها فزّاعة للداخل والخارج، من دون أن تتبنّى برامج جدّية للتغيير. وفي الوقت نفسه، ساهم فشل الحركات في بناء تحالفاتٍ عريضةٍ لمناهضة الدكتاتورية في إضعاف المعارضة. وقد طرحتُ مرّة مقترحاً بأن تحسم هذه الحركات أمرها لتخطّي الانسداد السياسي الذي ساهم تردّدها فيه: فإما أن تتّخذ موقفاً جريئاً وتتبع نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، بطرح برنامج واقعي تتحمّل بموجبه مسؤولية الحكم كاملة؛ وإما أن تساهم في بناء تحالف ديمقراطي واسع يتصدّى للاستبداد؛ أو أن تتنحّى عن الساحة السياسية وتترك المجال للقوى الديمقراطية الأخرى لتحمّل مسؤوليتها. وللمفارقة، كانت تونس هي الوحيدة التي جرى فيها تبني خيار بناء الائتلاف الديمقراطي، ولكن الحركة للأسف تخلت عنه بعد دخولها البرلمان.
في المرحلة الحالية الفاصلة من تاريخ تونس، ليس التحدّي مراجعة أخطاء الماضي، بل التصدّي لتحديات الحاضر. لم يعد التردّد وأنصاف الحلول يجديان، وعلى كل القوى الديمقراطية تحمّل المسؤولية كاملة، بدءاً بالاعتراف الصريح بتقصيرها في الدفاع عن الديمقراطية. ولا ينبغي أن تنجرّ هذه القوى مرة أخرى، كما يبدو أنه الاتجاه عند بعضهم، إلى تقديم “تنازلاتٍ” لامسؤولة أخرى، بل الأولوية هي لبناء تحالف ديمقراطي قوي، يتخذ موقف الهجوم لا الدفاع، ويحمل راية الديمقراطية، ولا تسمح لخصومها بتسجيل الأهداف في مرماها، فلم يعد هناك مناص من تحمّل المسؤولية الديمقراطية، ومعها المسؤولية عنها، كاملة.
العربي الجديد
—————————-
ترحيب فرنسي بإجراءات الرّئيس التّونسي… لكن ماذا بعد؟/ رندة تقي الدين
لدول المغرب العربي علاقات وروابط تاريخية قديمة بفرنسا، على اختلافها بالنسبة الى كل من هذه الدول. في تونس، بعد الخبطة المؤسساتية التي أجراها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو)، حين تخلص من رئيس حكومته هشام المشيشي وسدّد ضربة قاضية لرئيس حزب “حركة النهضة” الإسلامي راشد الغنوشي، الذي كان لمدة عشر سنوات يدير الثورة التونسية التي أطاحت نظام زين الدين بن علي، تنظر باريس بارتياح الى ما حصل، خصوصاً أنه لاقى تأييداً كبيراً من الشعب المستاء من التعطيل السياسي.
كان على الرئيس المنتخب من الشعب في تونس، بحسب الدستور، أن يستمد نفوذه من البرلمان الذي يمتلك “النهضة” فيه أكبر كتلة، وقد تحالف مع المشيشي الذي كان سابقاً مقرّباً من الرئيس سعيد. وقد تعطل العمل السياسي بسبب الخلاف بين الرئيس والمشيشي خلال أزمة كورونا الكارثية في البلد. وتتساءل الأوساط المسوؤلة في فرنسا عمّا سيتبع خطوة سعيد وما يريده الرئيس للفترة المقبلة وما هي خريطة طريقه. والتساؤل لدى البعض فيه شيء من القلق، ففي المرحلة الأولى كانت شريحة واسعة من الشعب مرتاحة الى ما قام به سعيد، لأن التعطيل السياسي في ظل أزمة كورونا كان كارثياً مع وضع اقتصادي ومالي يزداد سوءاً. لكن بعد ذلك بدأت تظهر مؤشرات قلق وتساؤلات شعبية وفي العواصم الخارجية عن المرحلة المقبلة وما سيفعله الرئيس. فقد قام سعيد بخبطة قوية امتنعت فرنسا عن وصفها بأنها انقلاب، علماً أنه ترجم الدستور على كيفه، إذ إنه لا يمكنه استخدام البند 80 من الدستور الذي يعطي سلطات استثنائية للرئيس إلا في حال وجود تهديد لأمن البلد. وهو اعتبر أن تونس كانت في هذه الحالة، ولكن في العادة يتم ذلك عبر المحكمة الدستورية التي تشرّع هذه الخطوة، وبما أنه ليس هناك محكمة دستورية، قرر وحده أن شروط تنفيذ البند 80 تتيح له القيام بذلك من دون استشارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المشيشي.
وأوضحت مصادر فرنسية أنه بكل الأحوال لم يكن مجبراً على أن يأخذ برأي الغنوشي والمشيشي، كون هذا الشرط استشارياً فقط. ثم إن الإجراءات التي اتخذها سعيد تذهب الى أبعد مما ينص عليه البند 80. فقد أقال رئيس الحكومة من دون أن يكون الحق له بذلك بحسب البند 80، وعلّق أعمال البرلمان، في حين أن البند 80 ينص بوضوح على أنه خلال تنفيذ البند 80 يبقى البرلمان منعقداً. ورغم ذلك تلقى الرأي العام التونسي خطوته بالترحيب نتيجة التعطيل، خصوصاً أنه لم تكن لسعيد القدرة الدستورية لحل المجلس من دون موافقة حزب الأكثرية، وهو “النهضة” الذي كان رافضاً لحل المجلس.
وأدت خطوة الرئيس الى إنهاء التعطيل السياسي، ولاقت ترحيب الرأي العام التونسي. لكن السؤال المطروح لدى باريس والاتحاد الأوروبي هو: ماذا سيفعل بعد ذلك؟ فبعد ثلاثة أسابيع لم يسمّ بعد رئيس الحكومة الجديد. وهو قام ببعض التعيينات لأشخاص مكلفين عدداً من الوزارات، لأن الدستور لا يسمح له بتعيين الوزراء. وامتنعت فرنسا عن اتخاذ موقف من الإجراءات التي اتخذها، لأنها اعتبرت أن قرارات سعيد أنهت تعطيلاً غير محمول، ولأن قراراته حظيت بتأييد واسع من الشعب. في الوقت نفسه ترى باريس أن الوضع القائم حالياً في تونس هو أن الرئيس وحده حالياً يجمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونظراً الى مدة 30 يوماً هي لتنفيذ البند 80، تمنّت العواصم الأوروبية عودة النشاط البرلماني في 24 آب (أغسطس)، رغم قناعتها بأنه لن يسمح بعودة نشاط البرلمان ونفوذه. وفكرة الرئيس سعيد هي إنشاء لجنة دستورية تضع مشروع دستور جديد في غضون ثلاثة أو ستة أشهر، يقدمه الى استفتاء شعبي. حتى الآن لم يوضح سعيد خريطة الطريق التي يريد السير عليها، ولكن المعلومات لدى باريس تفيد بأنه بعد مهلة الثلاثين يوماً تدخل تونس في مرحلة انتقالية، مع بقاء نشاط البرلمان معلقاً وإنشاء لجنة مراجعة الدستور، على أن يتم تنظيم استفتاء شعبي في غضون ثلاثة أو ستة أشهر على الدستور الجديد. وتتساءل المصادر المسؤولة في باريس والعواصم الغربية عما سيحدث خلال هذه المهلة، وهل يستمر في جمع السلطات كلها، وكيف يشكل اللجنة التي تراجع الدستور، وهل سيضع وحده المشروع الجديد للدستور، أم أنه سيشرك القوى السياسية والاجتماعية وأرباب العمل وغيرهم؟
لم تنتقد باريس خطوة سعيد لأنها كانت شعبية، ولكن الأسئلة اليوم عديدة عمّا بعدها. البعض في تونس رحّب بخطوته لأنه اعتقد أنها قد تبعد نفوذ حزب “النهضة”، والبعض الآخر أيّدها لأنه مستاء ورافض للأحزاب السياسية لفشلها منذ عشر سنوات في إدارة شوؤن البلد ومسؤوليتها عن حالته المتدهورة. وتسأل باريس اليوم عن مشروع الرئيس التونسي الاقتصادي لإخراج البلد من الأزمة. فسعيد أستاذ قانون، وهو اعترف بأنه ليس له أي خبرة في القطاع الاقتصادي. منذ 25 (يوليو) تموز اتخذ إجراءات بديهية بالقول للتجار أن يخفّضوا أسعارهم، والى المصارف أن تخفض مستوى الفوائد، ومنع بعض رجال الأعمال من مغادرة البلد لاتهامهم بالفساد، ولكن هذه ليست سياسة اقتصادية. والحكومة الخارجة كانت قد بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي. فهل يطلب سعيد من رئيس الحكومة الجديد الذي سيعيّنه أن يستأنفها مقابل تنفيذ إصلاحات غير شعبية؟ لأنه سيضطر الى تقليص عدد موظفي الدولة وهو كبير. وصندوق النقد يضطره الى خصخصة شركات وطنية عامة، وكل ذلك مناقض لخطاباته الشعبوية. ويخيم الضباب على رؤية باريس والغرب لما يريده سعيد بانتظار تعيينه رئيساً جديداً للحكومة، والمتداول بقوة حالياً هو اسم مديرة مكتبه ناديا أكاشا، وهي أستاذة في القانون معروفة بمعرفتها، ولكن ليست لديها خبرة واسعة في الاقتصاد، إضافة الى أسماء أخرى. فهل سيكون بإمكانه تصحيح الوضع الاقتصادي في البلد؟ وتقول المصادر إن اختياره رئيس الحكومة سيظهر إذا كان الاقتصاد أولوية فعلاً له. ويعتبر عدد من المراقبين في تونس أنه يعتبره أولوية.
الدول العربية الخليجية، لا سيما الإمارات والسعودية، تؤيد سعيد، ومصر أيضاً. فرنسا تنتظر إعلانه خريطة الطريق وتشاوره مع القوى السياسية الأخرى. أما حزب “حركة النهضة” فترى المصادر أن قيادته أعطت تعليمات بالتهدئة وعدم المواجهة مع الرئيس الى الآن.
النهار العربي
————————-
==================
تحديث 25 آب 2021
————————-
«الديمقراطية الانقلابية» في تونس: تمديد حتى إشعار آخر
رأي القدس
كان تطوراً متوقعاً أن يلجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قبل شهر، استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي كما زعم، وتضمنت تجميد عمل البرلمان وإغلاق أبوابه، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وإسناد صلاحيات تنفيذية غير محدودة لرئاسة الجمهورية. وخلال الشهر الذي انقضى أصدر سعيّد سلسلة قرارات متنافرة ومتضاربة معظمها لا يدخل أصلاً في اختصاص رئيس البلاد، مثل إعفاء وزراء أو قضاة أو مدير قناة حكومية أو موظفة ناطقة باسم الحكومة، وكذلك تعيين مسؤولين في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة كان أكثرها غرابة اختيار أحد المتهمين بواحدة من حوادث قتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 في منصب المدير العام لوحدات التدخل السريع لحفظ الأمن.
قرارات سعيّد تدل على رغبة صريحة في التفرد بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت ذريعة عدم العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو تاريخ تطبيق إجراءاته الاستثنائية، وثمة تسريبات جدية تشير إلى أنه يعتزم إبطال الدستور الحالي واستبدال نظام الدولة الراهن بآخر رئاسي وتعديل القانون الانتخابي بما يلغي القوائم لصالح الترشيحات الفردية. لكن سلوك التفرد انطوى وينطوي على أنساق مختلفة من التخبط والارتباك والتقلب والتناقض، لعل أحدثها عهداً سخرية سعيّد من المطالبين بخارطة طريق، داعياً «من يتحدث عن خرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا وليبحث عن الخرائط في كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية». ولقد تناسى أن أول المطالبين بالخارطة كان «الاتحاد العام التونسي للشغل» أحد أبرز الجهات المساندة لإجراءات الرئاسة، وأن طلباً مماثلاً أتى أيضاً من أطراف دولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وسواها.
كذلك يتناسى سعيّد أنه، باستثناء الإطاحة بزيد أو تعيين عمرو وإلقاء الخطب الرنانة، لم يحقق للشعب التونسي أياً من الوعود والتعهدات التي زعم الارتكاز إليها في تفعيل الفصل 80 من الدستور، خاصة تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة تتولى علاج ملفات عاجلة وخطيرة مثل تفاقم انتشار جائحة كورونا أو تقديم وصفات إصلاحية وتنفيذية يمكن أن تقنع صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات الحد الأدنى لاقتصاد تونس الآخذ في الانكماش والانهيار التدريجي. وحتى إذا اقتنع الرئيس أخيراً واختار الوزير الأول فإن الحكومة على الأرجح لن تكون سوى رهط من الموظفين لدى مكاتب الرئيس، لا تخضع لسلطة رقابية من البرلمان وليس لقراراتها أن تتجاوز إرادة الرئيس في ظل صلاحياته الاستثنائية الراهنة.
كل هذا بالإضافة إلى الحقيقة الكبرى التي تشير إلى أن سعيّد كان أول المنقلبين على منطوق الفصل 80، الذي يُلزمه بالتشاور مع رئيس الحكومة وليس إقالته على الفور، وإبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وليس تعليقه وإغلاق بوابة المجلس بدبابة، إلى جانب اشتراط الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا التي كان سعيّد هو الذي أصرّ على تعطيل إنشائها فظلت غائبة ومغيبة.
وإذا كان تمديد الإجراءات الاستثنائية متوقعاً، فالمفاجئ أنه لم يكن لشهر إضافي ثان بل حتى إشعار آخر، وفي هذا دليل جديد واضح على صنف «الديمقراطية الانقلابية» التي يواصل سعيّد فرضها في تونس.
القدس العربي
————————-
تونس… «حتى إشعار آخر»/ محمد كريشان
ها هو الرئيس التونسي يمدّد، كما كان متوقعا «التدابير الاستثنائية» التي كان اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي وتتمثل في تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وحل الحكومة وتجميع كل صلاحيات الدولة في يده.
إذن ما كان إجراء مؤقتا لشهر واحد قابلا للتمديد استند فيه الرئيس قيس سعيد إلى قراءته الخاصة للفصل 80 من دستور البلاد لعام 2014 أصبح اليوم تمديدا مفتوحا «إلى غاية إشعار آخر» مع الإعلان عن أن الرئيس «سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي».
وفي انتظار ما سيتضمنه هذا البيان المرتقب تزداد المخاوف من أن الرجل يسير في نهاية الأمر نحو ترسيخ حكم الفرد الواحد، بلا حسيب ولا رقيب، مستفيدا إلى أقصى حد من «قرف» الناس من سنوات الحكم السابقة، وما اعتراها من لوبيات فساد مختلفة ومواءمات انتهازية ومجلس نواب كاريكاتوري منفّر، وما صاحب كل ذلك من صعوبات معيشية وأزمة صحية بدت السلطات أمامها في حالة من العجز وانعدام المسؤولية.
وإذ يمضي الرئيس قُدما في طريقه الخاص، غير عابئ بأحد، فإنه لا يستفيد فقط من التأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به وإنما أيضا من الحيرة والانتهازية وقلة الحيلة لدى معظم الطبقة السياسية والنخبة بشكل عام. باستثناء أصوات قليلة رفعت صوتها لتقول إن ما تم هو انقلاب على الدستور، بغض النظر عن وجاهة الانتقادات القوية والمشروعة ضد منظومة الحكم الذي كانت حركة «النهضة» ركيزته الأولى، اتسمت معظم المواقف إما بالحرص على مسايرة المزاج الشعبي الأغلبي المؤيد بقوة لسعيّد، أو السعي المتزلف لموقع ما في منظومة الحكم الجديدة التي يريدها الرئيس، أو كليهما.
امتلأت الساحة بمواقف التأييد لسعيّد انتقاما من وضع لم يعد يطاق وتوسما للخير في الرجل مقابل تراجع التحفظات التي بدت في الأيام الأولى.. فها هو اتحاد الشغل ينتقل تدريجيا من الحذر والتحفظ على خطوة سعيّد إلى التفهم وصولا إلى نوع من التأييد الضمني بشكل أو بآخر، وها هي حركة «النهضة» نفسها، التي استقطبت غضب الناس جميعا، تتدرج من اعتبار ما جرى انقلابا إلى تهدئة اللهجة لاحقا في انحناءة للعاصفة وصولا إلى بيانات بدا فيها التودّد إلى رئيس الدولة مبالغا فيه ومفتعلا.
أما النخبة فقد بدت في مجموعها إما صامتة أو حذرة لتجنب الاصطدام بفورة الناس المؤيدة لسعيّد لكن خيبة الأمل الكبرى تمثلت في انخراط أسماء وشخصيات لامعة فيها فأبانت بذلك على ثقافتها الديمقراطية الرثة، ومن بينها كتاب ومفكرون وصحافيون وكذلك قانونيون يحرّفون القانون عن مواضعه خدمة لأهداف سياسية باذلين كل التحذلق لتزيين ما قام به سعيّد. من حق هؤلاء إظهار التأييد لمن يريدون لكن ليس من حقهم أبدا التعسف على القانون لتطويعه بلوي فاحش ومفضوح، مسايرين الرئيس في ما ارتآه ضمن قراءته الخاصة التي يريد تقديمها على أنها هي الصحيحة وما عداها جهل مطبق يستدعي عودة من يرى ذلك إلى المدارس كما تحدث عنهم الرئيس ساخرا.
لا أحد يدري بالضبط ما الذي سيقدمه سعيّد في خطابه المنتظر فقد سخر ممن طالبوه بخريطة طريق للمرحلة المقبلة وتعيين رئيس وزراء، كما لا أحد يدري ما إذا كان سيُقدم، كما يروج البعض، على تعليق العمل بالدستور وتكوين فريق ينكب على تعديله ثم عرضه على الاستفتاء دون أي حوار وطني واسع. هذا الحوار الذي يرفضه سعيّد مع الفاسدين، كما قال، لكنه في المقابل لا يتحاور مع أحد، بمن في ذلك تلك الأحزاب التي تهتف له بحماسة. الرئيس ترشح وفق دستور محدد أقسم اليمين على احترامه لكنه شرع منفردا في التجرؤ عليه لإلغائه أو تعديله على مزاجه دون أي تشاور، حقيقي أو شكلي، مع مكونات المجتمع وقواه الحية، وهذه سابقة خطيرة للغاية حتى وإن جارته فيها المؤسستان العسكرية والأمنية.
من الصعب إعادة صياغة المشهد السياسي لأي بلد في أجواء من احتكار السلطة وادعاء احتكار الصواب بهذا الشكل، مع الاكتفاء بالشعارات والقرارات والتعيينات المرتجلة المتناثرة هنا وهناك. ويزداد القلق أكثر عندما يقترن كل ذلك بحالات تعسف تمثلت في منع وسائل إعلام من العمل واعتقال البعض أو سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر في تحد للأصول القانونية المعروفة بتعلة الوضع الاستثنائي.
في أجواء كهذه، من الصعب سماع أصوات العقل والحكمة لكن عندما تهدأ النفوس سيتضح أن البلد في غالبيته وبمعظم طبقته السياسية إنما انجرف باستسهال عجيب في عملية إعادة انتاج حكم الفرد المطلق والزعيم «المنقذ» و»الملهم» الذي يتمدد أكثر كلّما وجد من يعبّدون له الطريق، رغم مرارات التجارب السابقة. كل ذلك إذا ما استمر وترسّخ فهو كفيل حتما بوضع حد درامي لما عرف بـ «الاستثناء التونسي» لتعود البلاد إلى «بيت الطاعة» الذي نعرف جيدا رعاتَه الحقيقيين من عرب وأجانب. فهل ما زالت هناك من فرصة للتدارك؟ أتمنى ذلك من كل قلبي.
القدس العربي
————————–
تونس.. حتى إشعار آخر/ شادي لويس
“من يتحدث عن الخرائط فليذهب إلي كتب الجغرافيا لينظر في البحار والقارات، وخريطة الطريق الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بثبات وعزم هي الخريطة التي وضعها الشعب التونسي”… بصيغة تهكمية ينكر الرئيس التونسي الخرائط السياسية. مصطلح “خرائط الطريق”، بمعنى مجموعة المبادئ العامة أو الخطوات اللازمة لتحقيق هدف ما، مصطلح استعارته العربية حديثاً من اللغات الأوروبية. وحقاً بالغ في ترداده إلى حد أن بات مثاراً للسخرية. يسخر سعيد هنا من فكرة “خرائط الطريق” ويدعو الباحثين عنها والمطالبين بها إلى الرجوع إلى الأطالس، تبدو المزحة ركيكة، تضع الدلالة المباشرة في مقابل الدلالة الكنائية، المعني الحقيقي أمام المعنى الملازم له. إلا أن ركاكة تلك المفارقة البلاغية المعكوسة ليست ما يعنينا هنا. ففي الجملة التالية مباشرة، يعدل سعيد عن تهكمه، معترفاً بخرائط الطريق، وبواحدة منها على وجه التحديد، موجودة بالفعل، فهو يسلكها، بصيغة المضارع، وسيسلكها باعتبار المستقبل. لكن أين هي؟
لا يمنحنا سعيد إجابة، لا في كلمته هذه ولا في غيرها، فشهر قد مر من دون أن يطرح الرئيس التونسي أي جدول زمني ولو تقريبي للخروج من الأزمة ولا أفكار عامة لحلها ولا أطراف للتفاوض في ما بينها. وفي نهاية المطاف، يلجأ الرئيس إلي البلاغة، أو بمعنى أدق القليل من الزخرفة الكلامية، مؤكداً فضيلتي “الثبات” و”العزم” في اتباعه لهذه الخريطة، تلك التي “وضعها الشعب” بنفسه، الخريطة المنكرة أولاً والمحتجبة تالياً، وحتى الآن. إلا أن الشعب وكما نعرف، يمكن أن يكون شعاراً فضفاضاً، ذاك الكيان المائع خطابياً، العصي على التمييز بعيداً من إحصائيات استطلاعات الرأي وفرز الصناديق الانتخابية، دال بلا مدلول، برنين خلاب للكلمة ومفزع في آن واحد. إلا أن معضلتي الشعب والخريطة، يتم حلهما ببساطة، وفي قيس نفسه، ما دام هو بعزمه وثباته قد بات تجسيداً للإرادة الشعبية وطالما أن المسار الذي يسلكه هو الخريطة. ويمكن إيجاز هذا كله في أن سعيد لا يتبع خرائط مرسومة سلفاً، بل يستبق هو الخرائط عبر الطريق الذي يشقه، بنفسه وباسم الشعب. وعلى هذا النحو، تعاد الخرائط إلي أصلها، فالطبيعة سابقة عليها، وليس العكس.
والواقع أن المشترك بين الكنايات والخريطة، هو أنها وسائط، أي ترميزات للمباشر وطرق للولوج إليه واستيعابه. و لا ريب في أن الرئيس الذي تم انتخابه من دون سند من حزب أو مؤسسة، قد جاء بفضل استياء الناخبين من تلك الوسائط السياسية، وبوعد ضمني منه بمحوها لصالح صورة من الحكم المباشر. وبعد فيض من الأخبار والإشاعات التي تشير إلى توقيف قاضيات بتهم فساد، ورجال دين، وإخضاع نواب برلمانيين للتحقيق أو للسجن على يد القضاء العسكري، بالإضافة إلي مؤامرات لاغتيال الرئيس وهجمات إرهابية، تبدو ضرورة تلك المباشرة الحصرية، وقد تم تأكيدها، فكل مؤسسة أخرى في الدولة، عدا شخص سعيد، ملوثة وموضع للشك والتشفي أيضاً. ومن اليسير، الحكم على العلاقة المباشرة بالشعبوية، لكن الإفراط في قولبة الواقع قيد التشكل في مصطلحات مجهزة سلفاً، لا يفيد كثيراً، سوى في إثبات صحة تعريفات دائرية، تلف وتعود إلي نفسها.
فبغض النظر عن التوصيفات، فإن المعضلة التي تواجهها تونس اليوم هي أن قوة سعيد تكمن في ضعفه، والعكس صحيح. فمن افتقاده لدعم أي وسيط سياسي، تتولد نزاهته وشعبيته، لكن سرعان ما يسقط الرئيس التونسي ضحية لتلك الوضعية، فمن دون تلك الوسائط، ومع تنحية كافة المؤسسات بوصفها غير مؤتمنة، تصبح تلك العلاقة المباشرة علاقة في اتجاه واحد، من أعلى إلى أسفل. وقبل، أن يمر وقت طويل، تتحول إلى لا علاقة، أو ربما إلى إيهام بعلاقة تخفى وراءها عمل واحدة من المؤسسات القليلة التي لم ينلها التشوية مؤخراً، أي الأمن.
بعد شهر، بلا برلمان ولا رئيس للحكومة وبتعليق ضمني للدستور، عاد الرئيس التونسي مساء الإثنين الماضي ليمدد تجميد البرلمان، لكن ليس بحسب المادة 80، التي اتهمه البعض بإساءة تأويلها في السابق. فهذه المرة، لا يلتمس سعيد أي سند من الدستور، فهذا وسيط فقد قيمته هو الآخر، ويبدو عملياً وقد تم إسقاطه. وفضلاً عن ذلك لا يُلزم الرئيس نفسه بمدى زمني لسريان التجميد، فيتركه مفتوحاً “حتى إشعار آخر”. تسقط تونس في حالة أكثر ضبابية من السابق، بلا خريطة طريق وبلا أفق زمني لحالة عدم اليقين، وبلا أي شيء سوى وعد بكلمة من الرئيس في القريب.
المدن
————————-
=================