كتاب “كيف نكتب التاريخ”.. إعادة النظر في اليقينيات
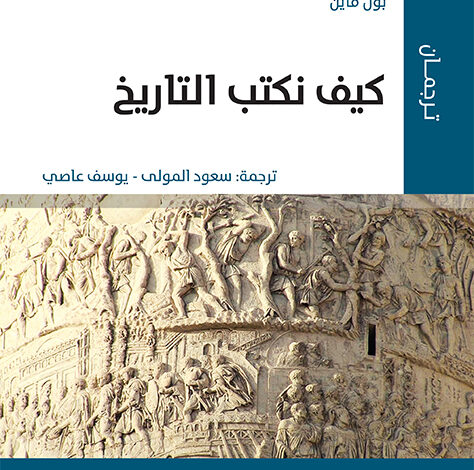
صدر عن سلسلة “ترجمان” في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب كيف نكتب التاريخ، وهو ترجمة سعود المولى ويوسف عاصي العربية لكتاب بول فاين بالفرنسية “Comment on écrit l’Histoire”. هذا الكتاب من نوع الإبستيمولوجيا التاريخية، أخذ فيه فاين مسافة واضحة من الماركسية كما البنيوية، وهما المقاربتان اللتان كانتا سائدتين في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، ليستند إلى منهج السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر الذي يعتبره عالمًا بالتاريخ أكثر منه عالم اجتماع.
حين صدر هذا الكتاب في عام 1971 اعتبره كثيرون مستفزًا، وأنه يعيد النظر في اليقينيات العلموية الشائعة في تلك المرحلة. والحال أنه جاء ليملأ فراغًا نظريًا في مباحث التاريخ، حيث كانت تسود الأرقام والمنحنيات والنظريات الاجتماعية الكبيرة المتأثرة بالماركسية حينذاك؛ إذ وقف فاين في وجه الخطاب المهيمن ليطرح مقاربة تقليدية إنسانية ملونة بشيء من الشكوكية. نعم، كانت نزعته الإنسانية واضحة من حيث إيلاؤه المكان الأول للفاعل التاريخي الذي رأى فيه حاكيًا راويًا للحقيقة. أما شكوكيته فظهرت في حذره من كل محاولات المفهمة الحديثة المظهر، سواء أجاءت من المدرسة البنيوية أم الماركسية. ولعل أهم ما في هذا الكتاب توكيده مفهوم الحبكة وقدرته السردية بما يشبه ما قال به بول ريكور بخصوص القص الحكائي، والذي يرى فاين أنه يغذي على نحو مبطن نظرية التاريخ.
موضوع التاريخ
يتألف الكتاب (536 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من اثني عشر فصلًا موزعة على ثلاثة أقسام. في القسم الأول، “موضوع التاريخ”، خمسة فصول. يقول فاين في الفصل الأول، “التاريخ ليس إلا سردًا حقيقيًا”، إنه لا وجود لحدث في حد ذاته، لكنه يكون حدثًا بالنسبة إلى تصور ما للإنسان الأبدي. ويشبّه فاين كتاب التاريخ بكتاب تعليم القواعد؛ “فالقواعد العملية للغة أجنبية لا تُحصي بشكل كامل جميع قواعد اللغة، لكنها تُحصي فحسب تلك التي تختلف عن قواعد اللغة التي يتكلمها القارئ، والتي خُصصت له ومن الممكن أن تُفاجئه. فالمؤرخ لا يصف بشكل مستفيض إحدى الحضارات أو إحدى الحقب الزمنية، وهو لا يُجري جردة كاملة لها وكأنه يهبط من كوكب آخر. إنه لا يقول لقارئه إلا ما هو ضروري كي يتسنّى لذلك القارئ تصور هذه الحضارة من خلال ما يُعرف أنه حقيقي في أي وقت”.
وفي الفصل الثاني، “كل شيء تاريخي، إذًا لا وجود للتاريخ”، يجد فاين أنه كلما زاد اتساع الأفق الحدثي أمامنا، بدت لامحدودية التاريخ أكبر: “وهكذا فإن كل ما تحويه الحياة اليومية للناس جميعًا، بما فيها ما قد يكشفه بمفرده أحد البارعين في كتابة اليوميات الحميمة، هو في الواقع صيد ثمين للمؤرخ؛ إذ لا نرى في أي ناحية من نواحي الوجود، سوى في الحياة، ويومًا إثرَ يوم، ما يمكن أن تعكسه التاريخية”.
وهذا لا يعني بالنسبة إليه أن على التاريخ أن يصنع من نفسه تاريخًا للحياة اليومية، إنما يعني ذلك أن أيّ حدث لا يُعرف إلا من خلال آثاره، وأن أيّ واقعة من الحياة بأسرها للأيام كلها هي أثر لحدث ما، سواء أكان هذا الحدث مصنفًا أم لا يزال نائمًا في غابة اللاحدثية. وفي رأيه، لو كانت العناية الإلهية توجه التاريخ، وكان التاريخ كليّة، لتعذر تمييز التصميم الإلهي؛ “فالتاريخ بوصفه كلية يفلت من بين أيدينا، وبوصفه تقاطعًا لسلاسل هو شواش يشبه اهتياج مدينة كبيرة يُنظر إليها من الطائرة”. ولم تكن الفلسفة الكلاسيكية تُشخصن التاريخ، بل كانت تكتفي بالاطلاع على أن عالمنا هو عالم الصيرورة والتوالد والفساد.
أما الفصل الثالث، “لا وقائع ولا صعيد، بل حبكات”، فيسأل فيه فاين: إذا كان ما حدث كله يستحق أن يكون من التاريخ، أفلا يدخلنا هذا الأخير في حالةٍ من الفوضى؟ وكيف يمكن واقعة ما أن تحوز دون غيرها قدرًا أكبر من الأهمية؟ كيف يمكن ألا يُختزل كل شيء إلى مشهد مملّ من الأحداث المفردة؟ وفي رأيه، ليست الوقائع منعزلة عن بعضها؛ ما يعني أن نسيج التاريخ هو ما سوف نسميه حبكة، أي مزيجًا إنسانيًّا جدًا مع قليل جدًا مما هو علمي من الأسباب المادية والغايات والمصادفات. إنها، بعبارة أخرى، شريحة من الحياة يقتطعها المؤرخ بحسب تقديره، حيث للوقائع روابطها الموضوعية وأهميتها النسبية. وبحسبه، ليست الأحداث أشياء، أو مواضيع متماسكة، أو موادَّ، بل هي تقطيع للواقع نقوم به بحرّية، ومجموعة من العمليات تعمل فيها وتكابدها مواد في تفاعل، أناس وأشياء.
الخصوصي والفكري
ويرى فاين في الفصل الرابع، “بدافع الفضول الخالص لما هو خصوصي”، أن المؤرخين شعروا دائمًا بأن التاريخ يتعلق بالإنسان ضمن مجموعة وليس الإنسان الفرد، وأنه كان تاريخ المجتمعات والأمم والحضارات، بل تاريخ الإنسانية، وتاريخ ما هو جماعي، في المعنى الأكثر غموضًا للكلمة. لكن أي مؤرخ أو عالم اجتماع يستطيع فصل ما هو فردي عما هو جماعي، أو حتى إعطاء معنى لهذه الكلمات؟
والحال أننا لا نُميز ما هو تاريخي ممّا هو غير تاريخي فورًا وعلى نحو فطري. ولرؤية مقدار تقريبية محاولات تعريف التاريخ هذه، والتي نُكثر منها ونختزل بها تباعًا، من دون أن نشعر أبدًا بأننا أصبنا الهدف يكفي أن نسعى إلى توضيحها. وفي رأيه، إذا جاز تعريف التاريخ بأنه معرفة الخصوصي المعيَن، تسهل مقارنة هذا التاريخ، وهو يعني تاريخ الأحداث الإنسانية، بتاريخ الوقائع المادية، كتاريخ الأرض أو النظام الشمسي. فيقول: “إننا نؤكد طوعًا أن لا شيء مشترك بين هذين النوعين من التاريخ، فتاريخ الطبيعة لا يهمّنا أبدًا كما يقولون، إلا في حال كون موضوعه موضوعًا ذا شأن، بحجم الكرة الأرضية، لكن لا أحد سيعمل على رواية أخبار عما حدث في بقعة من الأراضي الخالية من السكان. وعلى العكس من ذلك، فإننا ننظر إلى أصغر الأحداث في حياة المجتمعات البشرية على أنها تستحق البقاء في الذاكرة. إذًا يجب أن نستنتج من ذلك أننا قد نولي اهتمامًا متميزًا للتاريخ البشري الذي محوره الإنسان، وذلك لأن هذا التاريخ يحدثنا عن كائنات تشبهنا”.
وأخيرًا في هذا القسم، يقول فاين في الفصل الخامس، “نشاط فكري”، إن كتابة التاريخ نشاط فكري، “بيد أنه يجب الاعتراف بأن تأكيدًا كهذا قد لا يجلب اليوم ثقة أينما كان”. وفي رأيه، كتابة التاريخ في أساسها وفي غاياتها ليست معرفة كباقي المعارف، “وبما أن الإنسان بالذات هو في التاريخانية، فقد يولي التاريخ اهتمامًا خاصًا، وقد تُمسي علاقته بالمعرفة التاريخية أكثر مودة من علاقته مع أي معرفة أخرى، عندئذٍ يصعب فصل الموضوع عن الذات العارفة. وقد تعبر نظرتنا إلى الماضي عن وضعنا الحالي، وسنرسم أنفسنا ونحن نرسم تاريخنا. وبما أن للزمنية التاريخية شرط الإمكان الزمني للدازاين [وهي كلمة ألمانية معناها “الكينونة هنا”]، فهي تضرب جذورها في ما هو أكثر حميمية عند الإنسان”. ثم يضيف: “يُقال أيضًا إن فكرة الإنسان قد تكون خضعت في عصرنا لتبدل جذري، فقد أعطت فكرة الإنسان الأزلي مكانها لفكرة كائن تاريخي محض”.
في فهم الحبكة
وفي القسم الثاني، “الفهم” أربعة فصول. يفتتحه فاين بالفصل السادس، “فهم الحبكة”، فيقول فيه إن التاريخ لا يقوى على الاكتفاء بأن يكون سردًا، كما يُقال عادة، فهو يفسر أيضًا، أو بالأحرى، عليه أن يفسر، وذلك اعتراف بأنه لا يفسر دائمًا، وبأنه يمكنه عدم التفسير من دون التوقف عن كونه التاريخ. ويضيف: “التاريخ لا يُفسِر، بمعنى أنه لا يستطيع الاستنتاج والتكهن (وحده يستطيع ذلك نظام افتراضي استدلالي). ليست تفسيرات التاريخ إحالة إلى مبدأ يجعل الحدث مفهومًا، إنما هي المعنى الذي يضفيه المؤرخ على القص، فيبدو التفسير أحيانًا مستخلصًا من فضاء التجريدات”.
وفي رأيه، يؤلف كل قص تاريخي لحمة قد يكون تقطيعها إلى أسباب متفاصلة مصطنعًا، وهذا القص منذ البداية سببي ويمكن فهمه؛ إلا أن الفهم الذي يوفره يكون معمقًا تقريبًا. والبحث عن الأسباب هو رواية الواقعة بطريقة أكثر نفاذًا، وهو كشف المظاهر اللاحدثية للواقعة، وهو الانتقال من القصة المرسومة إلى الرواية النفسانية. فلا جدوى في مقابلة تاريخ سردي بآخر يطمح إلى أن يكون تفسيريًا. والتفسير في رأيه يعني الرواية على نحو أفضل، وفي أي حال لا نستطيع الرواية من دون تفسير. وأسباب واقعة ما، في المعنى الأرسطوي أي الفاعل والمادة والشكل أو الغاية، هي في الحقيقة مظاهر هذه الواقعة. وفي الأغلب ما تتجه كتابة التاريخ الحالية نحوه هو تعميق هذا القص.
أما الفصل السابع، “نظريات ونماذج ومفاهيم”، فيرى فيه فاين أن لا أشياء طبيعية في التاريخ، “ونعني بالطبيعية هنا أنها مثل نبتة ما أو حيوان ما، قد تؤدي إلى نموذجية أو إلى تصنيف. فالموضوع التاريخي هو ما نجعله أن يكون كذلك ويمكن تقطيعه من جديد بحسب ألف معيار ومعيار تتوازى كلها”. وتؤدي هذه الحرية الكبيرة جدًا بالمؤرخين إلى عدم القيام بالنمذجة من دون الشعور بفقدان الراحة. فعندما يَجمَعون الكثير من الأحداث تحت معيار جزئي لا يَسَعُهم منع أنفسهم من الإضافة على عجل أن الجوانب الأخرى لهذه الأحداث لا تستجيب للمعيار المختار، ما يبدو أمرًا مفروغًا منه. وفي رأيه، التاريخ المقارن (وقد نقول الشيء نفسه عن الأدب المقارن) هو شيء مبتكر في صوغه أكثر منه في نتائجه التي هي تاريخ من دون أي زيادة. وبتعبير أدق، فإن المصطلح الملتبس والزائف علميًا للتاريخ المقارن يعيّن منهجين أو حتى ثلاثة مناهج مختلفة: استخدام المماثلة لملء ثغرات التوثيق، وتقريب وقائع تم استعارتها من بعض الدول أو من أزمنة مختلفة لأغراض كشفية، وأخيرًا دراسة صنف تاريخي أو نموذج لحدث ما على مر التاريخ، بغضّ النظر عن وحدات الزمان والمكان.
السببية والوعي
وفي الفصل الثامن، “السببية والاستنتاج الاسترجاعي”، يستحسن فاين أن يتكرر الجنس البشري، أو على الأقل تتكرر كل حقبة زمنية بعض الشيء، “ومعرفتنا بهذا التكرار تسمح لنا بالاستنتاج الاسترجاعي”. وفي رأيه، تُستخدم كلمات مجموعة قوانين اللغة بالمعنى نفسه دائمًا، وتقتضي الأعراف أن نأكل وقوفًا، أو جلوسًا أو استلقاء، ولكن ليس كما نريد. ويرى فاين أن جوهر مشكلات المعرفة التاريخية يحتل مستوى الوثائق والنقد والتبحر العلمي. ويطمح تراث التفكر الفلسفي في مجال الإبستيمولوجيا التاريخية إلى هدف مرتفع جدًا، فهو يتساءل عمّا إذا كان المؤرخ يُفسر بواسطة الأسباب أو القوانين، لكنه يقفز من فوق الاستنتاج الاسترجاعي. إنه يتكلم عن استقراء تاريخي ويتجاهل المتسلسلة/ الوضع في تسلسل. غير أن إعادة تكوين تاريخ حقبة زمنية معينة تحصل بوضعه في متسلسلة، وعبر حركتي ذهاب وإياب بين الوثائق والاستنتاج الاسترجاعي. وليست الوقائع التاريخية التي هي ظاهريًا الأكثر اتساقًا سوى استنتاجات تضم في الواقع نسبة كبيرة من الاستنتاج الاسترجاعي. وإضافة إلى ذلك، يرى أنه مثلما تنطوي أدنى واقعة على مجموعة من الاستنتاجات الاسترجاعية، فهي تنتهي بالانطواء أيضًا على استنتاجات استرجاعية أكثر عمومية، تشكّل مفهومًا للتاريخ وللإنسان.
وفي الفصل التاسع، “ليس الوعي أساس الفعل”، يرى فاين أن تصرفات البشر تحتل، في تجربة المؤرخ، مكانًا خاصًا وتطرح الكثير من المشكلات الحساسة، وهي كثيرة: مشكلة علم اجتماع المعرفة، والأيديولوجيا والبنية التحتية، والأحكام القيمية في التاريخ، والسلوك العقلاني وغير العقلاني والذهنيات والبنيات. وبعبارة أخرى، جميع مشكلات العلاقات بين الوعي التاريخي والفعل، والتي تحتل، في الاهتمامات الحالية، مكانًا كبيرًا بحجم مشكلة العلاقات بين الروح والجسد في الفلسفة الكلاسيكية. وفي رأيه، عمل الإنسان يتجاوز إلى حد بعيد وعيه، وجُل ما يقوم به لا مقابل له في الفكر أو في العواطف، وإلا قد نختزل مجموعات ضخمة متمأسسة مثل الدين أو الحياة الثقافية، إلى حد لا يكون لها مقابل أصيل سوى لحظات متقطعة من الانفعال في الجزء الأرهف من الروح عند نخبة صغيرة.
وعمومًا يملك الإنسان طبيعة، وهو لا يُفسر كليًا من خلال تاريخه. إن نوعه وأعماله هي نفسها دائمًا وفي كل مكان تقريبًا، أو بتعبير أدق، إن سلم نشاطاته ومواقفه أقل اتساعًا مما كنا نتوقع قبليًا، والصعوبة التي يواجهها للخروج منها أكبر كثيرًا من ذلك، إنه ليس مخلوقًا من المصادفة، والحال أننا لا نرى في الوعي السبب الكافي لهذا التقييد الذي يعانيه أو يخدمه أو يعقلنه في أحيان أكثر مما يقرره عن بصيرة وعلم بالأمر.
تقدم التاريخ
وأخيرًا القسم الثالث، “تقدم التاريخ”، فيه ثلاثة فصول. في الفصل العاشر، “إطالة الاستبيان”، يقول فاين إن الواجب الأول للمؤرخ هو إثبات الحقيقة، والواجب الثاني هو إفهام الحبكة: إنما للتاريخ نقد، ولكن ليس لديه طريقة، لأنه ليس هناك طريقة للفهم. ويستطيع أي شخص إذًا أن يجعل نفسه فجأة مؤرخًا أو بالأحرى قد يستطيع ذلك، لو لم يكن التاريخ، لتعذّر الطريقة، يفترض أن يكون لنا ثقافة. لم تنفك هذه الثقافة التاريخية (يمكن تسميتها السوسيولوجيا أو الإثنوغرافيا، على حد سواء) تنمو، وأصبحت ذات اعتبار منذ قرن أو قرنين. وفي رأيه، يتم الإثراء الزمني للفكر التاريخي من خلال صراع مضاد لميلنا الطبيعي لجعل الماضي تافهًا. ويترجم بالإكثار في عدد المفاهيم المتاحة للمؤرخ، ومن ثم بإطالة قائمة الأسئلة التي سيعرف طرحها على وثائقه. ويمكننا تصور هذا الاستبيان المثالي على غرار قوائم “المواضع المشتركة” و”الاستلاحات” أو الأرجحيات التي كانت تدرجها البلاغة القديمة لاستعمال الخطباء. وليست المواضع التاريخية المطروحة مفيدة للتوليف فحسب، بل هي تساعد على تجنب ما تُظهره حالة الثغرات في الوثائق الأكثر تضليلًا على المستوى النقدي.
أما الفصل الحادي عشر، “الأرضي/ المعيش والعلوم الإنسانية”، فيجد فيه فاين أن القوانين والأحداث التاريخية لا تتطابق، وتقطيع المواضيع وفقًا للتجربة المَعيشة ليس كتقطيع مواضيع العلم المجردة، “وينتج من ذلك أن العلم، حتى لو كان منجزًا، قد لا يصبح مِطواعًا، ولا يمكننا عمليًا إعادة بناء التاريخ معه. وينتج من ذلك أيضًا أن العلم، حتى ولو كان مُنجزًا، فقد لا تكون أغراضه أغراضنا، وسنستمر في الاستناد إلى التجربة المَعيشة، وفي كتابة التاريخ كما نكتبه حاليًا. وليس هذه بسبب حبنا الاستمتاع بشيء ما من الدفء الإنساني. فلقد رأينا أن التاريخ لا يرتكز على الفرادة وعلى القيم، وأنه يسعى إلى الفهم، ويزدري الطرفة: قد لا تكون عندئذٍ التجربة المَعيشة سوى طرفة بالنسبة إلى التاريخ لو كان قابلًا للتحويل إلى علم. لكنه عمليًا ليس كذلك، فهو يحتفظ بثقله”. وبحسبه، إذا كان التقطيع العلمي والتقطيع الأرضي/ المعيش لا يتطابقان، “فذلك لأن العلم لا يقوم على وصف ما هو موجود، بل على اكتشاف الدوافع الخفية التي تعمل بكل دقة، على خلاف الأجسام الأرضية؛ فهي تسعى إلى الشكلي من وراء ما هو معيش”.
وفي الفصل الثاني عشر، “التاريخ، علم الاجتماع، التاريخ الكامل”، وهو الفصل الأخير في الكتاب، يسأل فاين: من أين يأتي أن علم الاجتماع موجود، وأن فائدته أعلى من فائدة طريقة التعبير المستخدمة من طرف المؤرخين؟ يقول: “السبب في ذلك أن التاريخ لا يقوم بكل ما ينبغي فعله، ويترك لعلم الاجتماع مهمة القيام به عوضًا عنه، حتى ولو تخطى الهدف. ولأنه مقيد بمنظور الأحداث يوميًا، يتخلى التاريخ المعاصر لعلم الاجتماع عن الوصف اللاحدثي للحضارة المعاصرة. ولأنه مقيد بالتقليد القديم للتاريخ السردي والقومي، يتشبث تاريخ الماضي، بشكل حصري جدًا، بالقص ملحقًا بمجموع متصل في الزمان والمكان. ونادرًا ما يجرؤ على رفض وحدات الزمان والمكان، ليكون أيضًا تاريخًا مقارنًا. والحال أنه يمكننا الملاحظة أن التاريخ إذا ما حزم أمره ليكون كاملًا وأن يصبح ما هو عليه بالتمام والكمال، فإنه يجعل علم الاجتماع غير مفيد”.
الترا صوت




