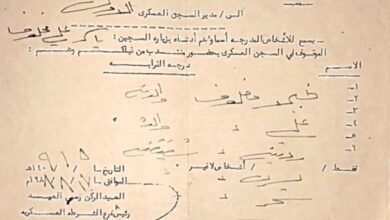طنجرة ضغط اسمها سوريا/ عمر قدور

تكتب على صفحتها صديقةٌ من سوريا لا تنقصها موهبة التكثيف أن المحسود الآن هو من تتاح له فرصة سفر خارج طنجرة الضغط التي يعيش فيها السوري، ومن تتاح له الفرصة يجب عليه التكتم درءً لحاسدين لا يتحملون بسبب بؤسهم رؤية محظوظ من بينهم يقفز ناجياً من التايتانيك.
ليس من قبيل المجاز الحديث عن مئات ألوف السوريين “على الأقل” الهائمين في الليالي في الحدائق القليلة والفسحات بحثاً عن نسمة هواء، بعد أن استحالت بيوتهم جحيماً بسبب انقطاع الكهرباء والماء، وبعد أن أضيفت إلى طوابير انتظارهم السابقة طوابيرُ شراء قوالب ومكعبات الثلج الجاهزة عندما يُتاح باعة لها. في أحياء دمشق وصلت ساعات انقطاع الكهرباء مؤخراً إلى 22 ساعة يومياً، وفي ريفها وصل الانقطاع إلى يومين أو ثلاثة أيام متتالية، قد لا يليها وصل الكهرباء سوى لساعة أو ساعتين تتخللهما انقطاعات عديدة.
لا كهرباء لضخ المياه، الشحيحة أصلاً، وحتى أصحاب المحال التجارية الذين يستخدمون مولّدات كهربائية خاصة صغيرة صاروا يقننون استخدامَه وفتحَ محلاتهم بسبب شح وغلاء الوقود اللازم لتشغيلها، وربما بسبب شح الزبائن. “الأحياء الراقية” من العاصمة، التي لم تكن تشهد انقطاعات من قبل، دخلت ضمن التقنين في الأيام الأخيرة لتصلها الكهرباء لساعة أو نصف ساعة بعد انقطاع لعشر ساعات أو أكثر. وهذا غير مبشّر لأهالي الأحياء الفقيرة أو المتوسطة، لأن انقطاعها عن الأحياء الثرية ينذر بأزمة حادة مديدة جداً.
الأمل الوحيد لهؤلاء الهائمين خارج بيوتهم أن ينتهي الصيف وموجات الحر الشديدة التي رافقته، وأن يطول الخريف الذي يليه دفعاً لشتاء سيشهد أزمة مشابهة في الكهرباء فوق أزمة الوقود الذي سيكون ضرورياً للتدفئة. والأمل برحمة الطبيعة يعكس وصولهم إلى اليأس التام من حلول قد تأتي بها الحكومة، بصرف النظر عن الموقف السياسي من السلطة، والأخيرة أقلعت عن تقديم الوعود ذات الصبغة العمومية من حيث نوعيتها وتوقيت تنفيذها، وكأنها قررت أن تكون صادقة مع محكوميها بتخليها عن التزاماتها تجاههم.
ببساطة، لا مؤامرة في قطع الكهرباء، والسلطة لا تعمد إلى قطعها لأي سبب كان. هناك قطّاع خدمي متهالك، وهو قد وصل مرحلة الانهيار شبه الكلي، وانهيار هذا القطاع الأساسي والحيوي “الكهرباء” ستكون له تبعات كارثية على كافة مناحي العيش والاقتصاد من دون حل سحري في الأفق. للتذكير، أزمة الكهرباء غير جديدة أو طارئة على السوريين، فهم عانوا منها بدرجات متفاوتة طوال حكم الأسدين، وحتى في الأوقات التي كان يتباهى فيها بتصدير الكهرباء إلى لبنان.
حسب البيانات الحكومية، وصل إنتاج الكهرباء قبل عام 2011 إلى 8000 ميغاواط، وهو الآن عند عتبة 1500 ميغاواط. إلا أن أرقام إنتاج الكهرباء لا تعكس وحدها الواقع الفعلي، ففي أحسن حالات الإنتاج لم يكن يلبّي الطلب بشكل تام، وكان هناك نوعان من الانقطاعات؛ الأول بسبب عدم كفاية الإنتاج، والثاني بسبب الأعطال المتكررة للشبكات. وكانت أعطال الشبكات تُعزى دائماً إلى زيادة في الضغط عليها، من دون استبدالها بنوعيات أفضل، وكانت التقديرات آنذاك تشير إلى هدر بنسبة 10% من الإنتاج بسبب تردي كابلات الشبكات الرئيسية وحده.
من المؤكد أن الحال تدهور خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى الانهيار، فبحسب إعلانات الأسد نفسه كان الإنفاق موجهاً إلى أولوية واحدة هي الحرب “على السوريين”، وكان على محكوميه التضحية بالخدمات الأساسية من أجلها. من المؤكد أيضاً أن الأعمال القتالية “بتعبير حيادي” قد دمرت نسبة مؤثرة من البنى الخدمية المتعلقة بالكهرباء والماء والمستشفيات، بل هناك ألوف الأدلة على القصف المتعمد لشبكات الكهرباء والماء والمستشفيات. كان جزء من تلك البنية بطبيعة الحال بحاجة لصيانة أو استبدال خلال العقد الأخير، وبدلاً من ذلك تعرضت بمجملها للتدمير الذي تتحمل قوات الأسد المسؤولية عن معظمه.
وللوضع الكهربائي المتدهور أهمية لا تتوقف عند ضرورته لكافة الأنشطة الحياتية، فهو نموذج تُقارن به منذ الآن قطاعات أخرى مرشّحة للانهيار. على المنوال ذاته، لم تشهد تلك القطاعات الأساسية عمليات تعويض بسبب الاهتلاك الطبيعي، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى زيادة الضغط على ما بقي صالحاً للاستعمال ومن ثم تقصير مدة صلاحيته المعتادة. ذلك ينطبق مثلاً على القطاع الصحي الذي قد تتأثر مستشفياته ومرضاه بانقطاعات الكهرباء، وفضلاً عن دمار عدد كبير من المستشفيات الذي سيؤدي إلى زيادة الضغط على المتبقي فإن ما تبقى يعاني من تقادم تجهيزاته وتوقف بعضها نهائياً عن الخدمة. يُذكر أن محطات الأسد التلفزيونية بثت استيلاء قواته على تجهيزات لمستشفى ميداني كانت تستخدمه المعارضة، مع تنويه مسؤولي وزارة الصحة مطوّلاً بحداثة تجهيزاته، التهمة التي تكشف عن نوعية ما في حوزة وزارتهم.
الحديث عن نصف تريليون من الدولارات على الأقل لازمة لإعادة الإعمار لا يأتي من فراغ، فالجزء الأقل من التقديرات يذهب إلى تعويض المساكن المدمرة، بينما يلحظ الجزء الأعظم منها خسائر البنية التحتية والخدمية. فيما يخص البنية التحية والخدمية يلزم التأكيد مرة أخرى على أنها لم تكن في حال جيدة قبل عام2011، والقليل من حسن النوايا يفترض تجديدها لتكون لائقة ومناسبة بخلاف ما كانت عليه طوال حكم الأسدين، ويستحيل تصور حدوث ذلك مع بقاء الطغمة التي تتلهف إلى إعادة الإعمار فقط لتكون بوابَتها الواسعة إلى مزيد من النهب والسمسرة على حساب المستحقين. ولعل استبعاد إعادة الإعمار لا يكون فقط بربطه بتغيير سلوك الأسد على النحو المعلن، إذ يكفي ربط إعادة الإعمار بتأكد الدول المانحة من مصير أموالها ليرفض بذريعة تدخلها في شؤونه الداخلية وخرقها سلطاته السيادية.
تقريباً، منذ زج بشار الأسد بطاقته التدميرية القصوى، كان هناك تعويل على حلفائه بأن يكونوا أكثر حصافة. بدأ ذلك مع الوصي الإيراني، واستمر مع الوصاية المشتركة الروسية-الإيرانية. وكما هو معلوم أضاف حلف الممانعة رابطة جديدة لأعضائه مع انقطاع الكهرباء من طهران وصولاً إلى لبنان، بما يعنيه ذلك من استخفاف بمواطني هذه الدول، أما موسكو المغرمة بسياسة الأرض المحروقة فحساباتها الاستراتيجية لا تلحظ السكان عادة. منفذ النجاة الوحيد تشير إليه حركة “الهجرة غير الشرعية” المتصاعدة من مناطق سيطرة الأسد عبر البحر، إنهم يرمون أنفسهم في اتجاه دول المؤامرة الكونية.
المدن