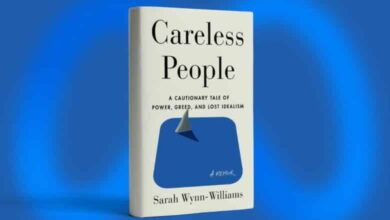الذكرى الثامنة لمجزرة الغوطة: كيمياء الأسد وانطباعية أوباما/ صبحي حديدي

في كتابه «خطّ أحمر: تكشُّف سباق سوريا وأمريكا لتدمير الترسانة الأخطر في العالم»، الذي صدر قبل أشهر بالإنكليزية عن منشورات Doubleday في نيويورك، يكشف جوبي واريك، الصحافي في «واشنطن بوست»، حكاية افتضاح تفاصيل ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيميائية ونجاح المخابرات المركزية الأمريكية في معرفة مقدار هائل من المعلومات عن طريق جاسوس سوري يدعى أيمن، وأطلقت عليه الاستخبارات الأمريكية لقب «الكيميائي». وهذا الأخير واصل عمالته طوال 18 سنة، قبل أن يقوده جشعه المالي إلى لفت أنظار استخبارات النظام العسكرية، التي لم تكن مع ذلك تشك في عمالته للمخابرات المركزية؛ فكان أن قاده مزيج من الخوف والطمع في العفو باعتباره بطلاً قومياً إلى الاعتراف بكل أفعاله، فانتهى به الأمر إلى ساحة الإعدام في سجن عدرا، سنة 2002.
ليست هذه السطور معنية بحكاية أيمن، إذْ لا تنطوي على جديد دراماتيكي في ملف نجاح أجهزة أمن أجنبية مختلفة في اختراق النظام السوري، على امتداد حكم حزب البعث منذ انقلاب 1963 وليس «الحركة التصحيحية» وآل الأسد منذ 1970 فقط. لكن الكتاب جدير بوقفة هنا، في مناسبة الذكرى الثامنة للضربات الكيميائية التي نفذها النظام السوري ضد الغوطة الشرقية، يوم 21 آب (أغسطس) 2013، وذهب ضحيتها قرابة 1500 شهيد بينهم عشرات الأطفال. وثمة أكثر من جزئية واحدة تستحث العودة إلى كتاب واريك، إلا أنّ الأبرز بينها قد تكون المعايير المزدوجة التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية المختلفة إزاء تضخّم ترسانة النظام الكيميائية؛ وهي، إلى درجة مذهلة من التطابق، المعايير ذاتها التي اتكأت عليها ديمقراطيات غربية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
وفي الصفحات الأولى من كتابه يسرد واريك أسماء الشخصيات المعنية بأسلحة النظام الكيميائية، فيبدو لافتاً حقاً العدد الكبير من الأشخاص الذين تعاطوا مع الملفّ في قليل أو كثير: 11 شخصاً في الأمم المتحدة، ابتداء من الأمين العام بان كي مون؛ 13 شخصاً، على مستوى عالمي، بينهم بوتين، قاسم سليماني، آية الله خامنئي، نوري المالكي؛ وأما المستوى الأمريكي فإنه يبدأ من البيت الأبيض (باراك أوباما، ومستشارته للأمن القومي كوندوليزا رايس، وتوني لبينكن وزير الخارجية الحالي الذي كان نائب مستشار الأمن القومي)؛ ولا ينتهي عند جون كيللي وزير الخارجية، وروبرت فورد سفير واشنطن في دمشق، وسامنثا باور المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. لا يغيب عن اللائحة فاعلون أقلّ شأناً من حيث المنصب والموقع، من دون أن يكونوا أقلّ فاعلية في تنشئة الترسانة عبر خدمات شتى، كما في أمثلة مدير شركة خطوط أسترالية تارة، أو مدير عمليات في شركات صناعات كيميائية مختلفة الجنسيات، أو ضابط بحرية دانمركي الجنسية…
ولم تكن الحصة الأمريكية في السكوت عن ترسانة النظام السوري الكيميائية قائمة على فراغ، أو منبثقة منه وإليه على نحو مفاجئ، بل كانت أحد وجوه تلك الحصيلة الجيو – سياسة لأربعة عقود ونيف من عمر علاقات واشنطن مع آل الأسد، الأب قبل الابن في الواقع؛ والتي نهضت على أشكال شتى من الدعم والمساندة والشراكة والتواطؤ، وليس على العداء والتناقض. عناصر الحصيلة شملت لبنان، منذ دخول جيش النظام بإذن أمريكي سنة 1976، والشروع في ضرب تحالف القوى الوطنية والمقاومة الفلسطينية في ذلك البلد، وشنّ حرب المخيمات على الفلسطينيين؛ ثمّ امتدت إلى «عاصفة الصحراء»، وانخراط وحدات من جيش النظام في تحالف «حفر الباطن»؛ كما انطوت على العنصر الأهمّ ربما، أي رضا دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نظام يوصف رئيسه بأنه ذاك الذي سلّم القنيطرة، والكثير من بطاح الجولان وقلاعه، من دون قتال عملياً.
ولم يكن عجيباً، استطراداً، أن باراك أوباما الرئيس الأمريكي يوم الضربة الكيميائية وصاحب وضع استخدام هذه الأسلحة تحت طائلة «الخطّ الأحمر»، اختفى عن الشاشات التي تناقلت أخبار مجازر الغوطة والمشاهد (الهولوكوستية بامتياز) للأطفال والنساء والشيوخ ضحايا جريمة الحرب القصوى الصريحة. وزراء الخارجية والدفاع والعدل ورئاسة المخابرات المركزية اقتدوا برئيسهم فتواروا عن العدسات المتسائلة، واكتفت الإدارة بتوكيل جوش إرنست، النائب الأوّل للسكرتير الصحفي، الذي أعرب عن «قلق» الولايات المتحدة إزاء تقارير الهجمات الكيميائية. بعيداً عن البيت الأبيض، قريباً من الكونغرس، أجاب الجنرال مارتن دمبسي، قائد الجيوش الأمريكية، على تساؤل النائب الديموقراطي إليوت إنجل، هكذا: «المعسكر الذي نختار دعمه [في سوريا] يتوجب أن يكون مستعداً لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما تميل الدفة لمصلحته. والوضع حالياً ليس كذلك».
قبل شهرين فقط كان أوباما قد رسم السياسة على نحو كريستالي الوضوح، كما يقول التعبير الأمريكي، مشدداً على أنّ استخدام أيّ سلاح كيميائي سوف يغيّر قواعد «اللعبة»، وبالتالي سوف يستدعي خطوات أخرى تصعيدية من جانب واشنطن، ضدّ النظام السوري. كذلك أعاد تأكيد الخطّ، مجبراً (بناء على نصائح مستشاريه) على التخفيف من التبعات ذاتها التي كان قد ألزم نفسه بها: «مهمتي هي أن أزن المصالح الفعلية الحقيقية والشرعية والإنسانية لأمننا القومي في سوريا، ولكن أن أزنها على أساس الخطّ الأساس الذي رسمته، وهو البحث عمّا هو أفضل لمصلحة أمن أمريكا والتأكد من أنني لا أتخذ قرارات مرتكزة على أمل وعلى صلاة، بل على تحليل صلب بمصطلح ما يجعلنا أكثر أماناً، ويكفل استقرار المنطقة».
وأمّا في الإطار العام المعلَن (ورغم المعلومات الغزيرة التي امتلكتها المخابرات الأمريكية عن الترسانة، بفضل العميل أيمن وسواه)، فقد اعتبر أوباما أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ما يزال مسألة «تصوّر»، أي أنه احتمال «انطباعي» فقط، وليس واقعة ملموسة ومرئية، تستند على أدلة مادية قاطعة. الإدارة، استطراداً، وفي المستوى المعلَن دائماً، ليست متأكدة بعدُ، أو ليست متأكدة نهائياً وقطعياً، من أنّ النظام السوري قد تجاوز ذلك الخطّ الأحمر الشهير. لهذا يصعب على البيت الأبيض «تنظيم تحالف دولي» حول أمر «مُتصوَّر» فقط؛ و»لقد جرّبنا هذا من قبل، بالمناسبة، فلم يفلح على نحو سليم»، قال أوباما، في إشارة (صحيحة، مع ذلك) إلى الخطأ الذي ارتكبه سلفه جورج بوش الابن في العراق.
والحال أنّ أيّ خطّ أحمر، لأيّ سلاح كيميائي أو جرثومي، لم يكن ذريعة أوباما في اتضاح، أو غموض، السياسة الأمريكية بصدد سوريا، ما خلا ّعقيدة أوباما» الشهيرة حول ترك الروس يغرقون في المستنقع السوري. ولا مفرّ اليوم في الذكرى الثامنة للمجزرة، من استعادة افتراض سابق، حوّلته مجازر الغوطة الكيميائية إلى حقيقة ساطعة، أخلاقية وإنسانية وسياسية في آن معاً: إصرار أوباما على حصر الخطّ الأحمر في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، جعل الأسد يعطي لذاته كلّ ضوء أخضر ممكن، لاستخدام كلّ سلاح، من المدفعية الثقيلة، إلى القصف الجوي، فالبراميل المتفجرة وصواريخ «سكود»، مروراً بمجازر العقاب الجماعي ومذابح التطهير الطائفي.
وحين عُقدت صفقة جون كيري/ سيرغي لافروف حول ما سُمّي «تسليم» ترسانة النظام السوري الكيميائية، لم يكن ينقص المسرح سوى مباركة إسرائيلية واضحة بدورها وصريحة، فلم يتأخر بنيامين نتنياهو في توفيرها، فهلّل للصفقة وباركها. وباستثناء واريك، ولكن بعد 19 سنة، لا أحد من شخوص المسرح سوف يتذكر العميل أيمن!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي