التضامن المدني مدخلنا إلى الديموقراطية/ د. راتب شعبو
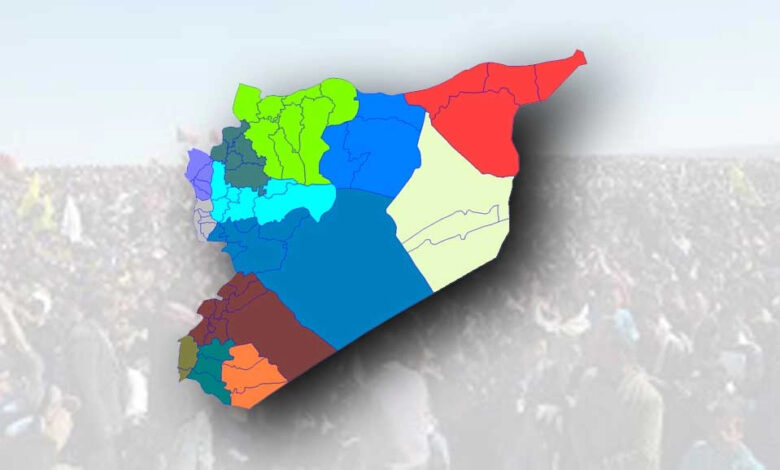
نكتشف اليوم، بعد عقد من اندلاع الثورات العربية، أن فشلنا في ترسيخ نظام سياسي ديموقراطي طوال تاريخنا ما بعد الاستقلال، لم يكن سببه أن الجيش والانقلابات العسكرية كانت أداة التغيير بمعزل عن الفعل والمشاركة الشعبية. ولعل الانقلابات كانت نتيجة أكثر مما كانت سبباً. أمامنا اليوم تجربة جديدة تقول إن الثورات الشعبية، السلمية وغير السلمية، فشلت في تحقيق ما تصبو إليه من انتقال سياسي ديموقراطي، بما فيها المجتمعات التي لم تصل فيها الثورة إلى العسكرة، واستطاعت أن تسقط طاغيتها سلمياً، مثل مصر، وأن تجري انتخابات رئاسية فعلية، ولكن دون أن تستطيع، مع ذلك، حماية هذا التحول وترسيخه، وارتدت إلى حال أسوأ من الحال الذي انطلقت منه.
نذهب في تفسير هذا الفشل إلى التراجع المزمن لعموم الناس عن الانخراط في المجال العام، بفعل غياب فكرة المشاركة في الشأن العام عن الوعي الشعبي، وبفعل انشغال النخب بالهم السياسي بمعناه المباشر (السعي إلى السلطة السياسية). سنحاول عرض والدفاع عن فكرة تقول إن السبيل الوحيد إلى الديموقراطية في مجتمعاتنا لا يكون في تسوية أو اتفاق بين نخب سياسية ، بل في المشاركة المباشرة للناس أصحاب المصلحة، وتنظيم حضورهم في المجال العام بشكل يحقق توازناً دائماً بين ميل نخب الدولة (السلطات) إلى الطغيان، وبين مصلحة الناس في حماية مصالحهم الحياتية اليومية والمباشرة، فضلاً عن مصلحتهم في حماية شروط الحياة العامة، الشروط التي غالباً ما تدوسها أقدام مصالح النخب المسيطرة والأنانية.
تاريخ شعبي نزق
دأبت السلطات المتتالية المتشابهة في طبيعة علاقتها بالمحكومين، على طرد الناس من المجال العام، جرياً على تقليد ثابت يلازم الطغيان، يقول إن المجال العام هو مجال سياسي حصراً، أي مجال اشتغال السلطة السياسية، إلى أن تكرس هذا الحال في الوعي على أنه الحال الطبيعي. أصبح ابتعاد المحكومين عن الشأن العام، عن شأنهم المباشر، عنصراً ثابتاً في تاريخنا، الأمر الذي يدفع إلى اعتبار أو، على الأقل، افتراض أن هذا العنصر مسؤول عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها مجتمعاتنا بين استبداد وآخر.
إذا تأملنا تاريخنا منذ الاستقلال، سوف نجد أن مشاركة الشعب في تغيير السلطة السياسية كانت محدودة. البارز في تاريخنا، قبل الثورات العربية التي ملأت العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، هو الترحيب بالسلطات وليس الاحتجاج عليها . يجري حسم الصراع على السلطة بين النخب، بعيداً عن الفعالية الشعبية، ثم يرحب الشعب بالسلطة الجديدة وكأنه في هذا الترحيب يستجلب خير السلطة المنتصرة ويستبعد شرها، كما لو أنها قضاء وقدر. هناك إذن ما يسوغ الانطباع بأن تاريخ السلطات والنخب لدينا مستقل عن تاريخ الشعوب، وكأن تأثير الشعوب في تاريخ السلطات وتعاقبها يقترب من الصفر.
تاريخ سياسي طويل كرس لدى الناس وعياً سلبياً تجاه المشاركة في الحياة العامة، الأمر الذي استقبلته النخب بترحيب لأن هذا الحال يوكل للنخب أهمية وشأناً على حساب المشاركة العامة، ويجعلها صانعة للتاريخ. ولكن من جهة ثانية، لا تجد النخب السياسية الحديثة التي تطمح إلى السلطة وتعارض السلطة القائمة، من سبيل إلى السيطرة السياسية سوى الاعتماد على الحركة الشعبية، ولاسيما بعد أن أُغلقتْ سبل الانقلابات العسكرية. هكذا ينشأ توتر، غير مجد، بين علو الاعتبار الذاتي للنخب وبُعد مقاصدها “السياسية”، وبين عجزها وحاجتها إلى مصدر قوة من خارجها (الجمهور) أو مصدر قوة خارجي (أجنبي).
سوف نجد أن النخب تعلي من شأن “الشعب” حين يتوافق مع رؤيتها ومصالحها، أما إذا كان مضاداً لها ولتوجهاتها، فإنها تحط من شأنه إلى حد الشتم، حين لا يكون لدى النخب سوى القول، وإلى حد القصف والحصار والإبادة، حين تكون النخبة معززة بجهاز دولة وجيش. على الشعب إذن أن يكون خادماً للنخب وليس العكس، أكانت النخب حاكمة أم معارضة. كأن النخب كانت تقول طوال هذا التاريخ ما قاله محمود درويش في “خطاب الديكتاتور”: “سأختار شعبى سياجا لمملكتي، ورصيفُا لدربي”.
الحالة الناتجة هي أن ينتظر الناس، مهما شقت ظروفهم، انقلاباً إنقاذياً (الانقلابات العسكرية تحمل في الغالب تسميات خلاصية وإنقاذية وتصحيحية)، يكنس انقلاباً سابقاً ليعيد العلاقة نفسها مع الشعب. نخبة سياسية تطيح بنخبة أخرى. وفي لحظات نادرة يقتحم الناس المجال العام من بابه الأقصى، نقصد الباب السياسي، للمطالبة بتغيير السلطة. ثم يعودون بعدئذ إلى مجالهم الخاص تاركين المجال العام للسلطة (القديمة أو الجديدة) لتعيد الاستبداد دورته الأولى التي تبدو بلا نهاية.
النشاط العام للناس يقتصر، والحال هذا، على أعلى أشكاله وهو الثورة الهادفة إلى تغيير نظام الحكم. هكذا تنوس الفاعلية الشعبية بين انسحاب طويل وكامل من الشأن العام، تاركين هذا الشأن حتى أدق تفاصيله للنخبة الحاكمة، وبين لحظات من ملء المجال العام بالانتفاض ضد النخبة السياسية الحاكمة مباشرة. بين الانسحاب التام والانتفاض السياسي يبقى المجال العام محل شغل حصري للسلطة السياسية القائمة، شاغراً من الفعالية الاجتماعية المدنية، أي من الحضور الشعبي المؤثر في المجالات التي تمس حياتهم اليومية. سوف نوضح لاحقاً التمييز بين الفاعلية المدنية المقصودة وبين أعمال الإغاثة والدعم، وعن أنشطة الجمعيات أو المنظمات التي تسمى منظمات غير حكومية.
هذا التاريخ الشعبي النزق كان دائماً وعاء لبؤس مديد مستقر، حين تكون السلطة طاغية والشعب مستسلم، أو لمجازر رهيبة حين ترتد السلطة بكل ثقلها على الناس الذين تركوا استسلامهم فجأة وخرجوا ضدها. تفسيرنا لهذه الظاهرة هو عدم اهتمام النخب بالنضالات على مستويات متدنية، أو أدنى من السياسة، الأمر الذي كرس انسحاب المحكومين الدائم من الشأن العام واستسلامهم المديد أمام النخب الحاكمة، بناء على تشكل وعي يظهر فيه الشعب مجرد أداة في صراع النخب، وأن هذا الصراع لا ينجم عنه فوائد ملموسة للناس، بصرف النظر عن لون النخبة المنتصرة.
دولة حديثة لمجتمع غير محدَّث
الدولة الحديثة التي توضعت في مجتمعاتنا من خارج سياق التطور الداخلي للمجتمع، كانت مكسباً ثميناً، ليس للمجتمع بل للاستبداد الذي اكتسب أدوات أكثر حداثة. جهاز حديث يمنح من يستولي عليه قدرة هائلة على إخضاع المجتمع الذي بوغت بالحداثة ولم يطور ما يكفي من الحماية في وجه جهاز دولة حديث تحركه ايديولوجيات حديثة أيضاً تحتقر وتفكك الروابط الأهلية على أنها متخلفة، وتمنع نشوء روابط مدنية حديثة عوضاً عنها، فيبقى الأفراد عراة وفريسة سهلة للجهاز (الدولة) الذي له سلفاً في الوعي العام مكانة شبه إلهية.
يظهر من تاريخنا الحديث، وجود تكامل بين الدولة الحديثة والايديولوجيات الحديثة، بين الدولة الحديثة بقدراتها الهائلة، والايديولوجيات الحديثة التي اجتمعت على عبادة الدولة وشرعت لها الانقضاض على الروابط الأهلية، وقمع نشوء بدائل مدنية لها. تكامل انتهى في الواقع إلى صلب المجتمع على خشبة السلطة السياسية. على هذا الحال، كانت الأيديولوجيات الحديثة (القومية منها والأممية)، عدائية ضد المجتمع، وتُرك الفرد الأعزل عارياً مما يمكن أن يحميه من بطش جهاز الدولة الحديث الذي قمع بثبات أي محاولة لنشوء وسائل حماية مدنية يدافع بها المحكومون عن مصالحهم المباشرة في وجه الدولة .
على هذا، فإن الأيديولوجيات الحديثة التي غذت أحزاباً وانقلابات عسكرية، أنتجت، حين نجحت في الاستيلاء على الدولة، بيئة مناسبة للاستبداد، تمثلت في تغليب الدولة على المجتمع، بوصفها الأداة في يد “الطليعة” التي سوف تحدث المجتمع. الحداثة المباغتة وتهميش المجتمع غير المحدَّث، أفسح المجال، في الواقع، لأن تتغذى كل نزوعات التسلط والعصبيات غير الحداثية في صفوف “الطليعة” (التي صارت طغمة حكم) داخل أغلفة حديثة . هكذا نمت، مثلاً، ظاهرة التوريث داخل الغلاف الجمهوري، وكذا الحال فيما يخص العصبيات العشائرية والطائفية التي نمت ضمن أغلفة حديثة أكانت قومية أو وطنية أو أممية .. الخ. ويمكننا تلمس هذه الظاهرة (نمو العلاقات الأهلية في أغلفة حديثة) حتى في الأحزاب السياسية التي قضت حياتها في معارضة الاستبداد السياسي. كانت الحداثة عندنا إذن مجرد غلاف للتخلف، وكانت مركباً لغير ما يفترض أنها مركباً له، فلم تكن مركباً للعقلانية و”نزع السحر عن العالم”، بل بالأحرى مركباً للاستبداد.
حداثة الدولة لم يواكبها حداثة على مستوى المجتمع الذي بقي موضوعاً سلبياً للسياسة، وبقيت العلاقة بين الدولة والمجتمع وحيدة الجانب، قائمة على علاقة الإخضاع والخضوع التي تنطوي على انعدام ثقة متبادل. ولم تظهر الدولة على أنها مؤسسة عامة تحرص على الخير العام، وهكذا بقي المحكومون على مسافة اغتراب دائمة عن دولتهم.
التيارات السياسية الرئيسية نظرت إلى الدولة إما على أنها جهاز في يد طبقة مسيطرة ودعت ليس إلى الاستيلاء عليه فقط بل وإلى تحطيمه أيضاً، كبداية لإعادة بناء المجتمع “السليم”، أو على أنها جهاز ينبغي أن يكون في يد أهل الربط والحل، أو في يد الطليعة. وفي كل حال ظل الشعور باغتراب المجتمع عن الدولة حاضراً، وظلت عتبة الشعور بعمومية الدولة عالية.
هذا الواقع غير المتوازن، حيث المجتمع منسحب ولا يعكس وزنه داخل جهاز الدولة، وحيث للدولة الوزن الساحق والأثر الأهم، نقول إن هذا الواقع دفع طالبي التغيير وأنصاره للتفكير في الاستيلاء على الدولة لما لها من قدرة. وعليه تركز دائماً الصراع في المستوى السياسي وحول الدولة، الأمر الذي زاد من تهميش المجتمع. ما سبق يفترض النظر بعين جديدة للبحث عن مقاربة نضالية تعيد التوازن بين المجتمع والدولة وتفكك أو تضعف قيود الاستبداد الراسخة والمزمنة فيه.
التضامن المدني، الاشتباك مع الطغيان على مستويات منخفضة
تقول نظرية التحديث إن تحديث البلد وتطويره على مستوى التعليم وزيادة دخل الفرد ونمو وسائل الاتصال والصناعة ..الخ، يقود إلى الانتقال الديموقراطي أو يشكل أساس التحول إلى الديموقراطية. وتقول نظرية الانتقال الديموقراطي إن الأساس في الانتقال هو الخيار السياسي للنخب السياسية، أي إن الديموقراطية ليست نتيجة “حتمية” لعملية التحديث، كما توحي النظرية الأولى . كلا الأمرين مهم في الانتقال الديموقراطي، ولا يمكن إغفال أي منهما، ولكن يبدو لنا، إضافة إلى أهمية العناصر التي تركز عليها النظريتان السابقتان، أن العامل الحاسم في نشوء واستمرار نظام ديموقراطي في مجتمعاتنا هو المشاركة المباشرة للناس على مختلف مستويات حياتهم اليومية، صعوداً إلى قضايا تهم مجتمعاتهم المحلية بصورة مباشرة.
أسوأ ما يقع على أذن السلطة الطاغية هي مفردة “التضامن”، على أن التضامن الأهلي (تضامن العائلة أو العشيرة مع أحد أبنائها) أقل سوءاً على أذن الطغيان من “التضامن المدني”، أي التضامن غير المرهون بعلاقة عضوية بين المتضامنين. يريد الطغيان، رغم كل الموارد والقوة التي يحتكرها، أن يواجه المحكومين كأفراد معزولين، ويسعى إلى تحطيم الروابط التي يمكن أن تحيل الأفراد إلى شعب ذي حضور وثقل يحد من حضور الطغيان وثقله. على أن الخوف من التضامن المدني قد يدفع الاستبداد، أحياناً، إلى تعزيز التضامن الأهلي الذي ينتهي إلى تفكيك المجتمع، في وجه التضامن المدني الذي من الطبيعي أن يوحده.
نرى أن بناء الفرد الحر أو المواطن هو عملية تبدأ من النشاط المدني (بما هو نشاط نضالي ينافس السلطة السياسية على المجال العام ويحد من سيطرتها عليه) قبل أن تنتهي في المستوى القانوني والسياسي. العملية هي الانتقال بالفرد من المجتمع الأهلي حيث يتعرف إلى نفسه على أنه ينتمي إلى عائلة أو عشيرة أو طائفة ..الخ، إلى مجتمع مدني يتعرف على نفسه كمواطن وينظر إلى الآخرين كمواطنين متساوين ومساوين له في المواطنة. هذا التحول الأساسي يحتاج، بالدرجة الأولى، إلى تأسيس شبكة حماية مدنية تغني الفرد عن شبكات الحماية الأهلية التي لم تنشأ أصلاً لحماية الفرد من بطش الدولة الحديثة بل لحمايته من تعدي جماعات أهلية أخرى.
الفشل في تكوين شبكات حماية مدنية، بصرف النظر عن الأسباب، كان من بين أسباب عدم ضمور الروابط الأهلية واحتفاظها بوظيفة الحماية في أيامنا، ولكن دون أي تناسب في القوى، لأنها وظيفة حماية في وجه دولة حديثة هذه المرة. الحماية الأهلية، والحال هذا من عدم التوازن، تتخذ شكلاً آخر غير المواجهة، فهي تتخذ شكل الواسطة أو المقايضة بالخدمات أو التواطؤ لصالح السلطة .. الخ. الكيان الأهلي يشتري حقوق أفراده بالمزيد من الخضوع للسلطة، وهذا يخلق لدى الأفراد الشعور بالحاجة للجماعة الأهلية التي تتقوى بدورها على حساب التضامن الاجتماعي المدني.
هذه التدخلات الحمائية من موقع الضعيف والمغلوب هي شكل حضور المجتمع الأهلي في الدولة، وهو شكل لا يتناسب مع ما يفترض أن يكون للمجتمع من قوة في الدولة. هذا فضلاً عن حقيقة أن هذه التدخلات قد تنفع في رفع الغبن عن الفرد، ولكن هذا غير متاح للجميع، بل لأقلية بالأحرى، ذلك أن غالبية السوريين لا ينضوون في عشائر متماسكة يمكن أن تتدخل لدى الدولة لحماية أفرادها، ولا يرتبطون مع أصحاب الشأن في الدولة بروابط دينية أو مذهبية أو قرابات، ولا ينتمون لعائلات كبيرة لها وزن اقتصادي أو ديني. غالبية السوريين يعيشون، في ظل الدولة الحديثة، عارين من الحماية تحت رحمة هذا الوحش الذي لا يرتوي من ابتزازهم وإذلالهم ونهبهم. وفوق ذلك، فإن الحماية الأهلية تخلق تمايزات بين الأفراد وبين الجماعات وتضر بالروابط المدنية وبنشوء الفرد الحر، أي تضرب أساس نشوء ديموقراطية تمثيلية، كما تجعل ثقل الدولة حاضراً في المجتمع أكثر من حضور المجتمع في الدولة.
لذلك لا تستاء السلطة الطاغية من تدخل زعيم عشيرة للمطالبة بحقوق انتهكتها الدولة لأحد أفراد عشيرته، أو من تدخل رجل دين له اعتبار، للمطالبة بحقوق أحد أفراد جماعته الدينية، في حين أن السلطة نفسها سوف ترتد بكل عنف ضد رئيس منظمة مدنية يحاول استرداد حقوق فرد ما. السلطة الطاغية تشعر كما لو بالغريزة، أن المطالبة المدنية خطر على سيطرتها المطلقة، ومقدمة لانتزاع المشاركة في الشأن العام أكثر فأكثر، على خلاف المطالبة الأهلية التي من شأنها، في الغالب، تعزيز سلطة الطاغية. نقول “في الغالب” لأن العلاقة الأهلية يمكن أن تشكل أحياناً قادحاً لتضامن مدني أوسع، يكون في هذه الحال تضامناً عفوياً، كما حدث في شرارة الثورة التونسية نهاية العام 2010، حين بدأ الاحتجاج على حادثة محمد البوعزيزي من قبل عائلته وعشيرته، قبل أن تشتعل نار التضامن المدني الواسع التي أشعلت الثورة .
بناء شبكة حماية مدنية تطال كل جوانب التعدي الممكنة على شروط حياة الأفراد هو النشاط الذي يتطلبه مجتمعنا، وهو المجال الذي يقترب من فكرة الديموقراطية المباشرة التي تلتفت إليها الشعوب الأوروبية اليوم وهي تتلمس حدود الديموقراطية التمثيلية وتبحث عن سبل المشاركة المباشرة.
من المفيد هنا، في سياق الكلام عن الديموقراطية، الإشارة إلى أن صاحب كتاب “العقد الاجتماعي” دافع عن أن المجتمع هو “الأمير” وهو “العاهل” وليست الحكومة سوى أداة بيد “الأمير الجماعي”. وأكد أن سيادة الكائن الجماعي تتناقض مع منطق التمثيل، فالناخب لا يكون حراً إلا أثناء عملية الانتخاب، وبعد ذلك يصبح عبداً لمن انتخبهم ويفقد حريته. وينتهي إلى القول إن سيادة المجتمع لا يمكن أن تفوَّض أو تُناب إلى أي سلطة. “تقوم السيادة، جوهراً، على الإرادة العامة، والإرادة مما لا يمثل مطلقاً، والإرادة إما أن تكون عين الشيء أو غيره، ولا وسط، وليس نواب الشعب ممثليه إذن، ولا يمكن أن يكونوا ممثليه، وهم ليسوا غير وكلائه، وهم لا يستطيعون تقرير شيء نهائياً وكل قانون لا يوافق الشعب عليه شخصياً باطل، وهو ليس قانوناً مطلقاً” .
لم يكن إذن جان جاك روسو متحمساً للديموقراطية التمثيلية، ولم يكن بعيداً عن فكرة الديموقراطية المباشرة التي تحقق التوازن بين المجتمع وسلطة الدولة، ليس عن طريق التعددية الحزبية والانتخابات وحرية الإعلام .. الخ، بل بالأحرى عن طريق المشاركة المباشرة للناس في تقرير شؤونها الحياتية، هذه الشؤون التي لا تفوض أو تناب إلى أي سلطة.
هل يمكن بناء شبكة حماية مدنية في ظل نظام يمنع أي نشاط مستقل؟ وكيف ومن أين يمكن البدء؟ وما علاقة هذا النوع من النشاط مع النشاط السياسي المعارض؟
تحقيق التوازن في مجتمعاتنا بين الدولة والمجتمع يتطلب بناء نشاط مدني مستقل ومواجه للدولة، إلى جوار النشاط السياسي المعارض ومستقل عنه أيضاً. النشاط السياسي المعارض يوسع مجال العمل المدني الذي يعود، حين يحد من سلطة الدولة في المجال العام، بالفائدة على العمل السياسي المعارض. استقلال هذين النشاطين عن بعضهما البعض يجعلهما متساندين.
النشاط المدني الذي يخلق شبكة حماية للأفراد في وجه الدولة، هو نشاط مواجهة مع السلطة بحكم الضرورة، لأنه في الأصل تعبير صريح عن صراع مصالح وإرادات. ولكنه نشاط لا يستهدف الوصول إلى السلطة، ولا تعنيه أيديولوجيا السلطة ولا لونها ولا من يشغلها، ما يعنيه هو صد مسعى السلطة للتضييق على حياة الأفراد المادية والمعنوية. لا يطالب النشاط المدني بالتعددية السياسية مثلاً، ولا ينشغل بشرعية أو نقص شرعية السلطة السياسية القائمة، بل يهتم أكثر بفساد السلطة أكانت شرعية أم لا، نظراً إلى أن الفساد يؤثر على حياة الأفراد بالمجمل. وتبقى عين النشاط المدني على هذا المستوى المنخفض (على افتراض أن السياسية تمثل المستوى المرتفع) الذي يعني الحياة المباشرة للناس .
لا تخضع حاجات الناس وآلامهم الناجمة عن صعوباتهم الحياتية لأي تباينات أيديولوجية. التباعد والصراع الذي تولده التباينات الأيديولوجية لا محل لها على مستوى الحاجات المباشرة. الأفكار والتصورات تباعد بين الناس بينما توحدهم الحاجات، ويمكن التأسيس على هذا لبناء شبكة حماية موحدة مستقلة عن النزاعات الذهنية الفارغة. نقول “فارغة” لأن الناس تحت ظل السلطات الطاغية يعيشون نفس البؤس بصرف النظر عن ذهنية السلطة أكانت إلى اليسار أو إلى اليمين. ومن الأجدى والأقرب إلى الحس السليم أن يوحدهم بؤسهم (العمل لتحسين شروط حياتهم المباشرة مادياً ومعنوياً) على أن تفرقهم الاتجاهات الفكرية للنخب (الأفكار الكبرى والأهداف غير المنظورة).
سعي الأحزاب السياسية المعارضة لإنشاء تنظيمات مدنية، مثل لجان الدفاع عن حقوق الإنسان أو منظمات الإغاثة والمنظمات الخدمية ..الخ، ليس هو ما نقصده في بناء شبكة الحماية المدنية. مع إدراكنا الفارق بين لجان الدفاع عن حقوق الإنسان (وهي جزء أساسي في شبكة الحماية كما نقصدها، على أن تكون مستقلة بالكامل عن تدخل الأحزاب السياسية) وبين المنظمات الخدمية. غير أننا نجمعها معاً هنا حين تكون تابعة لأحزاب سياسية أو ناشئة بمبادرة من أحزاب سياسية. إن تدخّل الأحزاب السياسية في النشاط المدني ينقل انقسامات السياسة إلى هذا النشاط ويفسده.
ما تدرج تسميته بالمجتمع المدني اليوم مثل المنظمات غير الحكومية أكانت في الإغاثة أو التدريب أو محو الأمية أو تنظيم الأسرة أو حماية الأطفال أو مكافحة جرائم الشرف ..الخ، لا صلة له بشبكة الحماية المذكورة. فهذه المنظمات تغطي ثغرات تخلفها المؤسسات العامة، وتعمل بالتفاهم مع السلطات القائمة وضمن شروط هذه السلطات. أي إنها تقوم إما بترميم ما تخربه السلطات أو بملء الفراغ الخدمي الذي لا تغطيه السلطات، دون أن تكون في أي لحظة في صراع مع هذه السلطات للحد من طغيانها.
النشاط أو الفعالية المدنية التي ينبغي على النخب أن تلتفت إليها، بدلاً من تركيز كل نشاطها في المستوى السياسي، هي مواجهة السلطة على مستويات منخفضة تتعلق بشؤون الحياة المادية والمعنوية. يحتاج النشاط المدني إلى نخب مدنية ترى أهمية هذا النشاط وأهمية ابتعاده عن الارتباط السياسي، سواء من ناحية الصلة بالأحزاب أو التشكيلات السياسية القائمة، أو من حيث التلوث بالميل الحزبي الذي يعني السعي إلى السلطة.
التسييس المفرط أو حلولية السلطة السياسية
يربط الوعي السائد عندنا كل تعدٍ أو خلل في إطار الحياة العامة، مهما كان، بالسلطة السياسية، ليس بمعنى المسؤولية العامة التي تستوجب معالجة الخلل، بل بمعنى تلازم الخلل مع السلطة القائمة، فيبدو أن إصلاح الخلل لا يمر إلا عبر تغيير السلطة القائمة. ولما كان التحرك إلى تغيير السلطة القائمة مهمة عسيرة ومحفوفة بالخطر، فإن النتيجة المتوقعة هي السكوت عن الخلل والاستكانة، أو توسل “الواسطة” لمن يستطيع سبيلاً، وإلا فلا سبيل سوى الرجاء وطلب “الرحمة”. في هذا الوعي ذي الطابع الديني، تبدو السلطة السياسية وكأنها “تحل” في كل تفاصيل الحياة، وكأن وجودها في التفاصيل والممارسات إنما هو وجود كامل وتام، كما تقول نظرية الحلول الصوفية. إذا مضينا خطوة إضافية في هذا التشبيه، يترتب علينا القول إذن إن الوجود الفعلي الحق هو للسلطة وليس للمجتمع وجود قائم بذاته لأن وجوده لا يتحقق إلا بحلول السلطة (الإله) فيه. والحق أن هذا الوعي ناجم عن سلبية تامة ومزمنة للمجتمع إزاء سلطة الدولة، وأن الوعي الحلولي يعود ليكرس هذه السلبية في إعلائه من سلطة الدولة وجعلها المبتدأ والمنتهى في تغيير أحوال الناس.
الوعي المذكور مسيطر، فهو مقيم لدى العامة كما لدى النخبة، ومقيم لدى المعارضة كما لدى السلطة. دائماً كانت تمتلئ سجون نظام الأسد، مثلاً، بأشخاص عبروا عن تذمرهم من أشياء فرعية، من ارتفاع الأسعار أو من الفساد أو من التشبيح. فالسلطة ترى في أي رفض فردي أو أي تذمر من تجاوز أو خلل أو صعوبة ما في الحياة اليومية، رفضاً لها وتذمراً منها، وتعالج الأمر على أنه كذلك، وتزج بالمتذمرين في السجون. وبالمقابل تشير النخب المعارضة إلى معاناة الناس على كل المستويات، من صغيرها إلى كبيرها، على أنها النتيجة “الحتمية” لبقاء السلطة القائمة في الحكم، وتستوعب إشارتها إلى معاناة الناس على أنها سبيل لفضح السلطة القائمة وخطوة على طريق إسقاطها. أي إن النخب المعارضة، حين تشير إلى مصاعب الناس وحاجاتهم ومعاناتهم، فإنها تتوسل ذلك لغاية سياسية، أي إنها لا تفعل ذلك لإرغام السلطة على تذليل الصعوبات وتلبية الحاجات ورفع المعاناة، ولعلها لا تريد لذلك أن يتم فتسقط من يدها وسيلة تحريض “سياسي”.
ينعكس هذا الوعي لدى عامة الناس على شكل يقول إن القبول بالسلطة القائمة، يعني أن تقبل بكل شيء يتعلق بالحياة العامة في ظلها (الأسعار، القدرة الشرائية، توفر المواد، الرشوة، حالة الطرقات، صنوف التشبيح .. الخ)، لأن تعبيرك عن رفض شيء من هذه يعني رفضك للسلطة القائمة وهذا يترتب عليه تبعات مواجهة مع هذه السلطة، فما بالك إذا طالبت أو سعيت إلى تغيير ما لا تقبل به. على هذا، لا يوجد في المجتمع أي نشاط أو أي محاولة أو تصور للعمل ضد الأحوال البائسة للناس باستقلال عن العمل ضد السلطة السياسية، أي باستقلال عن السياسة. والملاحظ أنه إذا تحرك المجتمع في وجه السلطة السياسية، فإنه لا يتحرك إلا لكي يطالب بتغييرها.
هذا الوعي الشعبي يقابله وعي مشابه ومعكوس لدى السلطة الطاغية، يصور كل مطالبة شعبية مستقلة على أنها موقف سياسي رافض للسلطة. النتيجة المنطقية لهذا التسييس المفرط هي السلبية الشعبية المزمنة. والحقيقة أن السلبية الشعبية أو غياب النشاط المدني يتكامل ليس فقط مع نزوع السلطة إلى التحكم التام بالمجتمع، بل ومع الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام وكل ما يعيق التنمية الاقتصادية والبشرية. وتفسير ذلك أن الاستسلام أمام تراجع شروط الحياة، يريح السلطات من العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ومكافحة الفساد والهدر ..الخ، ولاسيما أن الفساد، في أنظمة الطغيان، يعتبر من بين أهم عناصر تماسك النظام، ومن الطبيعي أن لا يميل النظام إلى سد قنوات الفساد وتحويل ما يذهب فيها إلى الصالح العام، طالما أنه لا يتعرض إلى ضغوط شعبية تطالب بتحسين شروط حياة الناس. وهذا ينطبق، وفق المنطق نفسه، على بقية العوامل التي تعيق التنمية.
الأهداف غير المنظورة تربة الاستبداد الممتازة
كانت دائماً الأهداف الكبيرة غير المنظورة وغير القابلة للقياس مدخلاً لصنوف الاستبداد. بعد الانتهاء من الاستعمار الفرنسي الذي شكل التحرر منه هدفاً محدداً وجامعاً للسوريين، بدأت التباينات السياسية بالظهور بين النخب السورية. كان هذا من طبيعة الأمور، غير أن المشكلة بدأت حين استقل التباين السياسي عن الأهداف الملموسة للناس وتحول إلى صراعات نخبوية حول الأحلاف والتيارات والأفكار الكبرى. الانقلابات والصراعات السياسية والاغتيالات كانت تحركها طاقة تنشأ من التصورات والأفكار أكثر مما تنشأ من واقع الناس ومعاشهم وشروط حياتهم. هكذا نشأت غربة بين الناس وبين الصراعات السياسية.
دارت الصراعات حول الوحدة العربية، والاشتراكية، ومعاداة الامبريالية، وتحرير فلسطين واستعادة الأمجاد ونصرة الإسلام ..الخ، باستقلال عن معنى هذه الصراعات في شروط حياة الناس. صارت الصورة معكوسة، إذ ترتب على الناس أن تنسى شروط حياتها وأن تنسى حرياتها، خدمةً لهدف كبير غير منظور ولكنه يملأ الصحف والراديو والكتب المدرسية، ويشكل مصدراً لا ينتهي للخطب والتصريحات. قبل الناس الجوع باسم الاشتراكية، وقبلوا سجن أبنائهم باسم الحرية، وشردوا باسم العداء للإمبريالية ..الخ. كانت الصراعات مموهة ومنزاحة دائماً عن المضمون الحقيقي لها، أي عن حقيقة أن الصراع كان في أصله من أجل المزيد من السيطرة للنخب الحاكمة، وأن الهدف غير المنظور ليس سوى ترخيص للسلطة بعمل أي شيء في “خدمة الهدف”. الأسوأ هو أن الناس ارتضوا، بتأثير النخب التي في السلطة وفي المعارضة معاً، أنه يجب تحمل ضيق الحال لصالح “الهدف”.
هذا هو تعريفنا للإيديولوجيا التي ينبغي التخلص منها. ستر الواقع بغطاء فكري يعطي السلطة صلاحية مطلقة وحتى مصادقة “أخلاقية” على تعزيز ترسانتها القمعية، وعلى صنوف البطش والتحكم. يصبح تجويع الناس وحتى سجن الناس وقتلها، عملاً في خدمة الهدف النبيل. رفض الأيديولوجيا، مفهومةً على هذا النحو، يقتضي ربط النشاط العام بالمصالح الملموسة للناس، ويقتضي تحرير المجال السياسي من الأهداف غير المنظورة وغير القابلة للقياس لصالح أهداف محددة وملموسة ويمكن قياسها.
هذه هي المقدمة الضرورية لنشوء روابط أو تشكيلات للنضال المدني الذي يقيس نتائج السياسات ويرصدها وينشرها على العموم ليخلق ثقافة للناس تخص أحوالهم المباشرة. هذه ثقافة مفقودة لدينا، ليس فقط بسبب التعمية التي تمارسها السلطات، بل أيضاً بسبب إهمال النخب المعارضة لهذا المستوى من النضال بوصفه نضالاً إصلاحياً وغير لائق و”أقل من المستوى”.
بالمقارنة مع بلد ديموقراطي راسخ مثل فرنسا، تجد السياسي الفرنسي، أكان في السلطة أم خارجها، ذا اطلاع جيد على واقع بلده، ويتكلم بإسهاب على التفاصيل الحياتية للناس وبالأرقام، فيما يسهب السياسي عندنا بالكلام العمومي والأفكار الكبرى وينشغل بإدانة خصومه أكثر مما ينشغل بنقل حقائق مفيدة للناس. هذا مؤشر على ما ذهبنا إليه.
قد يقول أحد إن المقارنة باطلة بين مجتمع ديموقراطي مستقر وغني، وآخر فقير ويحكمه استبداد مديد، ولكن المشاكل الحياتية الصعبة التي كان يعيشها السوريون دائماً، وإن بشدات مختلفة، تدفع إلى جعلها منطلق نضالي أكثر من الظروف الحياتية في فرنسا. كما أن مستوى الفساد في سورية، وهو السبب الأساسي لضيق حال السوريين والكابح الأساسي لكل تنمية في البلد، من الطبيعي أن يدفع النخب بالأحرى إلى جعله موضوع نضال مستقل، دون تأجيله بدعوى ارتباطه “العضوي” بالنظام السياسي. إن أي نظام سياسي، بصرف النظر عن الهدف غير المنظور وعن الغاية “النبيلة” التي يرفعها، سيكون تربة منشئة للفساد ما لم يكن هناك رادع مدني وليس سياسي فقط. الأحزاب السياسية المتنافسة يمكن أن تحد من تمادي بعضها البعض، ولكنها يمكن أيضاً، حتى لو توفرت شروط ديموقراطية معقولة، أن تتقاسم الفساد على حساب الناس.
من جهة أخرى، قد يقول أحد إن شروطنا الوطنية، أي احتلال جزء من أرضنا، ووجود إسرائيل، يفرض على النخب تكريس همها للنضال الوطني الذي يمكن أن يثقل على أحوال الناس ومعاشهم. من المفهوم أنه لا يمكن التساهل في احتلال جزء من الأرض الوطنية، ويتحتم إعطاء هذا الأمر حقه في كامل السياسة الوطنية، لكن لا يمكن أن يتماشى هذا الهم الوطني مع الفساد المستشري، ولا مع القمع المعمم، ,لا مع التضييق على أحوال الناس. ما يعني أن النضال ضد الفساد والقمع والفقر هو نضال من أجل القضية الوطنية مباشرة.
في ثورات الربيع العربي كافة لم يكن الهم الوطني هو المحرك، على خلاف ما كان الوضع عليه من قبل، حين احتل الهم الوطني المجال وسيطر على الهم الاجتماعي. تحركت الثورات العربية بدافع اجتماعي، كان هذا تحول مهم في طبيعة الصراع مع السلطات القائمة. غير أن ثورات الربيع العربي، ولاسيما الموجة الأولى، ولأسباب تتعلق بالشروط السياسية التي فرضها الاستبداد المديد، رفعت بدورها أهدافاً غير محددة وغير منظورة: حرية، كرامة.
هل الديموقراطية هي الحل؟
هل يكون انعدام شرعية السلطة السياسية في مجتمعاتنا هو مصدر التشنج الأمني الدائم لديها وخشيتها من أي نقد وارتدادها العنيف ضد أي نشاط مستقل حتى لو كان مطلبياً؟ وهل يبدأ حل أزمة العلاقة بين السلطة والمجتمع بحل مشكلة الشرعية؟ هل تكون الديموقراطية هي الحل؟
تدور فكرة الديموقراطية، كما يبدو في المشهد السياسي الحالي، حول الانتخابات وصناديق الاقتراع. ويمني الديموقراطيون أنفسهم بأن اعتماد الانتخابات لإنتاج السلطة السياسية، سوف يكون بداية لتعميق المشاركة والمبدأ الديموقراطي في مفاصل المجتمع. بهذا المعنى شهدنا تجربة ديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير 2011، انتهت إلى عودة الديكتاتورية العسكرية بأسوأ مما كانت عليه قبل الثورة. وهي تجربة جعلتنا نشهد خروجاً شعبياً واسعاً (تجاوز في حجمه الخروج الشعبي على مبارك) ضد أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، بعد أقل من عام واحد من ولايته. كما أننا نشهد منذ سنين تجربة ديموقراطية انتخابية في لبنان والعراق. في كلا البلدين تقوم الديموقراطية على تقاسم طائفي تعززه أحزاب طائفية، وعليه يقوم النظام على ركائز متعددة ولا يحتاج إلى ديكتاتور فرد، ويستطيع استيعاب تبادل السلطة ضمن دائرة النخب المسيطرة. الديموقراطية التمثيلية وتداول السلطة وغياب الديكتاتور الفرد، لم يكن سبيلاً إلى تحرير المجتمع من الفساد والقمع ولا إلى تعزيز الاجتماع الوطني. وقد شملت الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي هذين البلدين (العراق ولبنان) بسبب البؤس السياسي والاقتصادي البالغ فيهما. ومن اللافت أن هذين النظامين “الديموقراطيين” أكثر ثباتاً في وجه التغيير من الأنظمة المستبدة التي تقوم على مركزية الزعيم أو الديكتاتور.
هشاشة الديموقراطية المصرية القصيرة الأمد جاءت، على خلاف الحال في العراق ولبنان، من أنها تقوم، إلى حد كبير، على خيار الفرد الحر، ولا تقوم على أساس طائفي، أي إن هشاشتها جاءت من كونها كانت أقرب إلى المعنى الفعلي للديموقراطية.
تكرار القول إننا بحاجة إلى، أو إن خلاصنا يكمن في، صياغة عقد اجتماعي جديد (كناية عن دستور جديد، ذلك أنه لا معنى آخر للعقد الاجتماعي بعيداً عن التفكير في نشوء الدولة)، يغفل حقيقة أن أي عقد يحتاج إلى توازن قوة يحميه. كل قانون يحتاج إلى قوة لفرض القانون. وقوة فرض القانون ينبغي أن تبقى حاضرة دائماً، وإلا يتحول القانون إلى حبر على ورق، ويصبح القانون الفعلي تابعاً لميزان القوى القائم. لا بد من التفكير بالقوة التي تجعل العقد الاجتماعي (الدستور) نافذاً. الاستبداد هو، في حقيقته، خيانة لكل التوافقات والدساتير والعقود التي لا يستطيع المجتمع حمايتها.
خاتمة
كلما سيطر الهدف البعيد غير المنظور وغير المحدد، كلما كان الباب إلى الاستبداد واسعاً أكثر. الانطلاق من الأهداف القريبة والمباشرة من خلال النشاط المدني يحقق غرضين أساسيين، الأول هو شد الناس إلى المشاركة فيما يخص حياتهم اليومية والملموسة، الأمر الذي لا يمكن بدونه أن نتخلص من الطغيان السياسي، والثاني هو أن النشاط المدني يطور معرفة دقيقة في أحوال الناس، ولاسيما بعد هذا التطور الكبير في وسائل التواصل والتقصي، وهذا يسمح بقياس جدارة السلطة السياسية من خلال معايير تحسن أحوال الناس المادية (مستوى المعيشة) والمعنوية (مستوى الكرامة وسيادة القانون).
سوف يصطدم النشاط المدني (مفهوماً على أنه نشاط نضالي ضد شمولية السلطة السياسية) بعقبتين أساسيتين، الأولى هي السلطة الطاغية التي تحتكر المجال العام وتمنع أي نشاط مدني مستقل. والثانية هي الوعي العام الذي يرى أن الشأن العام هو شأن السلطة السياسية، ووعي النخب التي تحتقر العمل المدني.
العمل المدني يتطلب، إذن، نشاط ميداني يواجه الاستبداد على مستويات منخفضة أي غير سياسية، ونشاط ثقافي يشرح أهمية هذا النضال ويضعه في إطاره الصحيح، ويميزه عن بقية الأنشطة المنسوبة إلى المجتمع المدني.
قلمون – نيسان/أبريل 2021




