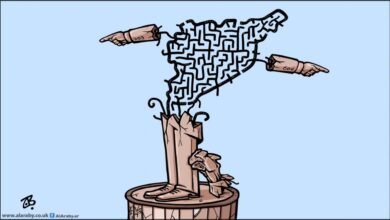الخطابة والإيديولوجيا والشعبوية في “خطاب الثورة”!/ موفق نيربية.

“الخطاب الثورجي بطبعه إقصائي. خطاب متجاوز للأعراف والآداب؛ يعتمد على الحشد والتجييش. أركان هذا الخطاب التشويه والتلفيق… إنه يُصدّر الكراهية، ويؤزّم حالة أهله الذين يتوجه إليهم.”
هذه الكلمات هي اقتباس- بتصرّف بسيط وغير مؤثّر- عن معلق رياضي خليجي محبوب اسمه عادل التويجري، توفي مؤخراً وهو في عزّ شبابه. والرياضة حياة، كما قال الأسد الأول سيئ الذكر، لذلك قد تصيب لغتها بأكثر مما تصيب اللغة المحترفة.
ليس سهلاً أن يتصدّى الإنسان لمهمة تفكيك خطاب الثورة السورية خلال عقد مرّ من عمرها، لأنه سيتعرّض غالباً لأناس كان يحبّهم، وغالباَ ما زال يفعل، ومعظمهم حسن النية لا يقصد إلّا تطوير حالة “ثورته”.
حيث أن مفهوم الخطاب في المجال السياسي أو الاجتماعي هو نص كلامي؛ يحتوي على رسالة أو مجموعة من الرسائل، مصاغ بصيغة محكمة، ويهدف إلى تمرير الأفكار والآراء بين فئات المجتمع، وتعد غايته الأساسية التأثير في الآخر. أو هو باختصار تعميم وتجريد لمفهوم المحادثة على أي شكل من أشكال الاتصال… وقد انتشر بقوة لدينا منذ حوالي نصف قرن، تعبيراً عن فعل “التواصل” بالحديث الشفهي أو الكلام المكتوب، في نقاش أو حوار أو مجادلة أو سجال أو مناظرة أو مخاطبة أو بيان أو مقالة أو كتاب أو محاضرة…إلخ
فيما يلي معالجة جزئية لخطاب الثورة السورية خلال عشر سنوات، من منظور ناقد، ومن بعض الزوايا.
***
الخطاب والخطابة:
نبحث- نحن السوريين في كلّ مكان وصلنا إليه- كثيراً، وخصوصاً مؤخراً، في أسباب تعثّر حالنا وحال ثورتنا. ولم يعد يصلح أو يليق بنا تعليق كلّ فشلنا على مشجب العوامل الخارجية. ذلك يصبح بدوره جزءاً من “الخطاب الثورجي” حين يفيض عن الواقع أو حتى عن الحاجة؛ بالطبع إلّا في حقل العلاج النفسي، وتنقّله بين حيّز الفرد وحيّز الجماعة.
ولطالما كان الجامع مكاناً لتلك الممارسة والتواصل، كما كانت “الخطبة” مصبّاً أساسيّاً، إضافة إلى “الدرس” الذي كان في القديم شغلاً للأساتذة من المفكرين والفقهاء والمتكلمين، ثمّ اقتصر حديثاً- في الجامع- على موجز تلقيني قد يكون مجرّد مقدمة لجلسة صوفية أو “حضرة”.
ورد في مناهج تدريس الخطابة في جامعة الأزهر أنها “فنّ مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة”. كما أكّدت في أكثر من موضع على أن أهم العناصر المحددة لعلم الخطابة هي أنها تتوجّه إلى جمهور وليس إلى مجرّد أفراد قلة؛ وأن إلقاء الخطبة ينبغي أن يتمّ بصوت جهوري يتكيّف في ارتفاعه وانخفاضه، شدّته وضعفه، توزيع سرعته وبطئه، تدفّقه وسكتاته، كلّها حسب الموضوع والهدف المقصود؛ وإلى أنه ينبغي أن يحمل كلّ عوامل الإقناع بالهدف المراد، ويكون بالنتيجة قادراً على استمالة جمهور مستمعيه واكتسابهم لصفّه.
وكثير من خطباء الثورة السورية كانوا أو ما انفكّوا من خطباء الجمعة، يتقنون قليلاً أو كثيراً فنون افتعال المواضيع والجمل الجاهزة التليدة، ويستطيعون أن يملؤوا دلواً كبيراً بها ينهلون منه عند الحاجة. ومعروفة قواعد تدريس الخطابة، وتركيزها على موسيقا الكلمات والجمل وانسيابها نحو غايتها، من الصراخ والتحذير إلى التنبيه إلى المعاصي، حتى الوصول إلى الهدف، والختم عليه بما يريح من الأدعية المختارة تبعاً للمناسبة، التي لا يندر أن تكون مجرّد تجميع للناس وتقريع لهم أو تحريض أو دعاية أقرب إلى تلك الانتخابية منها. وليس الجامع مقصوداً بذاته هنا، بل “الاجتماع” بكلّ أصنافه وأعرافه وأهدافه وأطيافه.. المقصود هو الخلط بين مفهوم “الخطاب” الأصيل ومفهوم “الخطابة”، أو إن الثاني اختلاط من اختلاطات الخطاب عندما يعتلّ، عند العرب والسياسيين، وكذلك الثوار.
خطابنا والإيديولوجيا:
على بعض تعريفات عبدالله العروي، تأتي الإيديولوجيا على أنساق ثلاثة: انحراف في انعكاس الواقع في الذهن، ونسق فكري يقوم بحجب هذا الواقع لأنه يحتاج إلى جهد في رؤيته لا وقت ولا قدرة لدينا لبذله، أو استعارة لنهج أو نظرية خارجية لم تستطع اختراق المجتمع، مع أنها تقترب ببطء من ذلك على الدوام كما تبدو من خارجها علي الأقل.
وعلى عكس ما فعل العروي، يمكن هنا التركيز نسبياً وحسب على النسقين الأول والثاني، بدلاً مما فعله من تركيز على الثالث. سبب ذلك هو ما نريده من تناولنا لمسألة الخطاب ذاتها.
لم يستطع خطاب الثوار في سوريا التعامل مع واقعة الاستبداد الأسدي المديد مثلاً، ليستنتج مباشرة أهمية برمجة الديموقراطية، على الرغم من هيمنة مفهومي الكرامة والحرية منذ اليوم الأول، لأن تلك الهيمنة كانت موسيقية غنّاء أساساً، ولم يجر تعميق وعيها على ما كان ينبغي. ولم يستطع ذلك الخطاب اختراق جدار المستقبل بالنظر والحركة، فأحلّ مكانه الماضي، واستسلم بسهولة للخطاب الكامن وراء الزاوية منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي، منتظراً فرصته عند تجلّي وتجسّد طائفية النظام ليظهر طائفيته، وعنفَ النظام كي يبدأ بتنظيم وإشهار عنفه.
ابتدأ مكتوماً انحراف الوعي عن واقع التأخّر الاجتماعي- الثقافي أيضاً، جانبياً باتّجاه يحجب ذلك الواقع، ويزيّف معرفته ليكسيها غرضاً مختلفاً. تمدّد بذلك وعي “كفر” النظام وأهله، لينتج أهدافاً على غير نسق ومقام، تقوم على “إعلاء كلمة الله”، ونشر رايته في الأرض. في ذلك قام ذلك الوعي الزائف بتوحيد “الذات- الهوية” مع التاريخ، بكلّ منتجاته التي كان أهل النهضة يعملون على غربلتها وفرزها، عبثاً بالطبع والتطبّع.
قابل ذلك الانحراف والحجب استعارة نظرية لعلوم الثورة، وفرائض الحداثة، واستعداد رائع للإبداع في الطرق. وللتضحية التي تقرّب الانتصار. إلّا أن تلك الاستعارة لم تكن عضوية بمنعكساتها على الأرض، ولا معمّمة أيضاً، أي لم تخترق الواقع لا أفقياً ولا شاقولياً. فلم يحتج النظام وأجهزته القمعية إلى أكثر من التركيز على “اصطياد” هؤلاء بالاغتيال أو الاختطاف أو التشريد والدفع باتّجاه الخارج.
لم تستطع إذن تلك الطليعة الممتازة تخليق خطاب بديل أقل انحرافاً وأكثر إنارة لوعي الواقع ومطابقته. وسادت على الفور ثنائية تضع في المقدمة تلك الإيديولوجيا الإسلاموية بكل تفريعاتها من جهة، وإيديولوجيا للمنفعة والأمان والتسليم في الجهة الأخرى. فكان من الطبيعي أن تنمو وتتكاثر الطروحات الطائفية التي حلتّ مكان الوعي والروح السلمية لدى الطرفين، إضافة إلى كلّ أشكال التشويه والتشوّه الأخرى.
ولعلّ العلّة الأكبر كانت في المعارضة العتيقة، التي قامت باجترار وعيها الذي أكل الدهر عليه وشرب، وقامت بشحذ عدّتها الإيديولوجية التي قامت عليها قبل نصف قرن على الأقل. فاستمرّت بصراعاتها وحزازاتها، وتسابقت على رضا الشبان الثوار من دون نتيجة حاسمة، لأن هؤلاء أيضاً قد اندفعوا لتجريب احتمالات توظيف تلك المعارضات في جسم الثورة بشكل مفيد… عبثاً في الأعمّ الغالب.
ظهر الانحراف أيضاً في منع التوجّه نحو تنظيم المعارضة وقوى الثورة الديموقراطية بشكل منتج وفاعل، يركّز على المستقبل وحاجاته، ليطوّر في البديل القادر على إنهاء الاستبداد ومنع احتمالات تجديد هيمنة الاستبداد السابق، أو استبداد جديد يأتي متقدّماً من بين صفوف الثورة ليركب انحرافاتها ويتمكّن.
وكذلك في حَرف برامج الثورة كلّها واختزالها في شعار “إسقاط النظام”، الذي كان خطابنا يرفض أيّ شعار يجاوره ويحدّد معالم دولة المستقبل. شارك بهذه العملية كلّ الأطراف الإسلاموية معتمدين على خيارات” الأغلبية”، التي لا يرونها إلّا من منظار الطوائف. ولكنهم لم يكونوا وحيدين، بل ساعدتهم أطراف ونخب لم يبق لديها فيما تعيه إلّا إيديولوجيا تتغذّى على روح الثأر والانتقام، لتاريخ من السجن والتعذيب والموت والتشريد لم يتخلّ عنه النظام، ولم يتنكّر له عملياً، بل طوّر فيه على الدوام. وفي واقع الحال وخلفيته، كانت الروح الانتقامية تلك ولا زالت هي العامل الحاسم نفسياً في صياغة وعي ومطالب الإسلامويين أيضاً، من خلال إعادة إنتاج لا تهدأ ودمدمات وزمازم لنشيد المجازر وفظائع حماة وحلب وتدمر. وعي ذلك ومنطقه الداخلي والتعاطف معه بعمق لا يغيّر من أثره على المسار ولا ينبغي له ذلك.
***
خطابنا والشعبوية:
في بحث حديث حول الشعبويّة اليمينية وديناميات أسلوبها وأدائها السياسي الإعلامي، عُرِضت طرق وأمثلة جديدة عن انعكاس ذلك الأسلوب في الأداء التواصلي، من خلال تقديم استخدام منظم ومستنير من الناحية المفاهيمية لـ “الأسلوب”، الذي يتجاوز المعنى الوصفي المستخدم بشكل روتيني في الاتصال السياسي. على وجه التحديد، يستكشِف البحث كيف يمكن لمنهج تحليلي للخطاب الشعبوي الإعلامي أن يتوجه الفهم الحالي لـلأسلوب الشعبوي ذاته ”ويتعزز من خلال تحليل بعض الخيارات اللغوية والخطابية المنتجة سياقيّاً في الأرشيف الخطابي الشعبوي”. وتمّ ذلك بتناول ثلاثة أمثلة من اليونان (حزب الفجر الذهبي) وفرنسا (الجبهة الوطنية) وبريطانيا (حزب استقلال المملكة المتحدة)، باستخدام نماذج من الأداء الخطابي لزعمائها في المقابلات والبيانات والتصريحات والمناشير على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُقال في الواقع إن الأسلوب الشعبوي لا يمكن تعريفه من حيث سمة واحدة، أو مجموعة من السمات المشتركة بين جميع الشعبويين اليمينيين وهي قابلة للنقل من سياق اجتماعي ثقافي إلى آخر؛ ولكن بشكل أكثر فائدة باعتباره مجموعة من الخيارات المحفزة بين الموارد السيميائية البديلة (اللغوية/ الخطابية والتفاعلية والبصرية)، والتي لها صدى اجتماعي وثقافي. وبالتالي، فإن هذا التركيز على ميزات المستوى الجزئي للتفاعل الوسيط يوفر فهماً أكثر دقة للأسلوب مما هو عليه الحال حالياً، لأنه يوضح كيف تقع الأنماط الأدائية للسياسيين الشعبويين اليمينيين في إطار اجتماعي ثقافي وثقافي محدد، كان أوروبياً في الدراسة المذكورة ونحاول توطينه محلياً في هذه المقالة، بإيجاز يحاول أن يتجنّب الاختزال.
الكلام عن مركزية الأسلوب في تجسيد الشعبوية، لا يعني أن الأخيرة ليست سوى أسلوب. وليس هذا هو المكان المناسب لإجراء مناقشة متعمقة للمفاهيم المختلفة للشعبوية. ومع ذلك، فإننا ننظر إلى الشعبوية على أنها خطاب سياسي، أو “أيديولوجية ضعيفة التبلور”، تمثل السياسة والمجتمع على أنه مُنظّم من خلال علاقة عدائية عميقة بين “النخبة” و”الشعب”، وبين” المؤسسة” وأدائها وأولئك والمحرومين من نعمها. وهي موجودة في كل من اليسار واليمين، ولدى العلمانوي والإسلاموي من الطيف السياسي.
كان ملهماً للكثيرين في العالم ما حققته التيارات الشعبوية اليمينية في أوروبا والأمريكيتين، بعد أن كان الأمر حكراً منذ نصف قرن على اليسار وقوى “التحرّر الوطني”. وانصبّ الاهتمام على ملاحظة أداء الشعبويين في العالم المتقدّم وأسلوبهم، للاشتقاق منهما محلياً. بل إن الدروس قد انتقلت مباشرة عن إعلاميين أكاديميين كانوا قد تابعوا دراساتهم في الغرب. ويمكن ملاحظة المثل الذي تعطيه قناة الجزيرة، والكوادر المؤسسة فيها هي ما ورثته بالكامل من تركة الإذاعة البريطانية، لتتصاعد النبرة المحرّضة فيها معتمدة على تلك الكوادر بعد أن ملأت وقودها من الاستراتيجية القطرية، وإثارتها للعواطف باتجاه محدد.
لا بأس هنا بالإشارة إلى أهم برنامج في قناة الجزيرة (الاتّجاه المعاكس)، لعب دوراً مهماً في الدفع باتّجاه ساد بالتدريج لاحقاً، يعتمد الخط الإسلاموي، ويدعم اتّجاهات التسلّح والراديكالية، ضمن سياق عام عنوانه دعم الثورة السورية. كما يمكن الإشارة أيضاً إلى قناة أورينت، التي تدحرجت سريعاً من كونها قناة أقرب إلى النخبوية والاهتمام العضوي الرفيع بالقضايا السورية قبل الثورة، إلى التركيز على طائفية النظام لتحريك الطائفية المضادة فيما بعد؛ ومن الاهتمام بالبنى الداخلية وتطوير الوعي الاجتماعي السياسي الثقافي إلى تصعيد الراديكالية مهما بلغت أخطارها المرافقة. كما لجأت تلك القنوات دائماً إلى اصطياد المعلقين والمحاورين الأكثر إثارة وعدائية في اللغة، بغض النظر عن القدرات الحقيقية لهؤلاء المشاركين على تقديم مادة مفيدة في تطوير الوعي والمعرفة. يمكن ملاحظة تلك الظواهر من دون التقليل من الاحترام المهنية العالية في الأداء في جوانب أخرى، في القناتين المذكورتين.
انعكست تلك الشعبوية بقوة في كلّ المراحل منذ اندلاع الثورة السورية على خطاب بعض الإعلاميين الشبان، الذين فاقت سمعتهم بسرعة سمعة الآخرين من أصحاب المستوى الأكثر صلابة مثل المجمّعات التي كانت تدور حول “لجان التنسيق المحلية” مثلاِ. ولكنّ تلاحق الأنفاس الذي يكونّه النوع الأول من الإعلام، يشجع على متابعته أكثر، ويشجّع في الوقت نفسه أولئك الإعلاميين على التضخيم واستعمال مفردات الإثارة والمبالغة، وأحياناً على التلفيق الذي يتآمر الملقي والمتلقّي على اعتماده، بل وتصديقه لاحقاً.
كما انعكست كذلك في تحرير اللغة من وقارها في أحيان كثيرة، وفي تضمين الشتائم والإشارة إلى الخصم بالاعتماد على المفردات الجنسية أو التركيب الدرامي أو الخرافة الروحية. ظهر ذلك في الخطاب الذي يقوم إعلاميون شبان بتصديره، وفي الخطاب الممارس داخلياً بعيداً عن الكاميرا وآلة التسجيل، بل إن مراجعة تلك المقاطع والتسجيلات كانت تتمّ أحياناً لمنع ظهور ما يشي بالطائفية مثلاً من الظهور.
في الكثير من الأحيان أيضاً كان- ولا زال- مستخدماً اتّهام أعضاء في “المؤسسة” أو المؤسسات بالسرقة والانتفاع من الثورة باستسهال عجيب ملتبس بقوة من الناحية الأخلاقية، إضافة أيضاً إلى “التلويث” بالاتهامات القائمة على الجنس. أما “العمالة” للدول الداعمة، أو للنظام نفسه، فهي من أسهل الطرق للتشويه والتأثير، مع تجميع معلومات عن المستهدفين يتمّ فيها جمع الحقائق مع “البهارات” الضرورية.
بالطبع فإن الجميع في حقل السياسات يرغبون بإقناع أعداد أكبر من الناس بالالتفاف حولهم وانتخابهم كقادة، وفي ذلك يكون للأسلوب والأداء الدور الحاسم في تقرير النتيجة. وهنا يمكن تمييز الخطاب الشعبوي من الآخر “التقني” أو الفعال والحقيقي، بكون الأوّل يلجأ إلى سلاح “العاديّ” في مواجهة “النخبة”، والمهمّش في مواجهة “المؤسسة”، والعاطفي أو الانفعالي في مقابل الواقعي والعلمي، والعاميّ في مقابل الفصيح، والشفوي في مقابل المكتوب، والمرتجل في مقابل المدروس، والتصعيد مقابل التهدئة، والكسل الاستسهال والاستعجال مقابل التعب والعمل والاجتهاد، والتوجّه نحو “الجمهور” لتحريكه بدلاً من تنظيم يبدأ بالنخب الاختصاصية…إلخ
***
يقوم أسلوب الخطاب المعنيّ على استخدام موارد متنوعة دلالياً وبطريقة تفاعلية، كما يدّعي القرب من الناس ويصطنعه من خلال إحياء الهويّات العصبية الأكثر عمقاً، كما يعتمد على السياق اللاهث والعابر للتحرّك من خلاله بما لا يعطي فرصة لأناقة النخب وهدوئها؛ وأخيراً يستخدم هرمية محددة لحكم القيم أو القيم والمستوى الأخلاقي مستنداً إلى ديناميكية المثير والجذاب، ومعتمداً على “الضجيج” لحجز الفضاء واحتلاله.
ولا ريب أن هنالك الكثير في أداء وأسلوب “النخب السائدة” و”المؤسسات” ما يعطي دفعاً للخطاب العابر السطحي المحبط في النتيجة؛ وقد حدث ذلك منذ قيام ثورة ٢٠١١؛ وتجسّدت الأسباب المباشرة آنذاك في ضعف المعارضة الرسمية وانقساماتها التافهة وانعدام تجربة الشبان الثوار السياسية.
وفي كلّ المراحل استعانت تلك “النخب” المعارضة السورية بأصحاب الخطاب الشعبوي وأدواتهم وأساليبهم ليكسبوا نقاطاً على خصومهم الأقربين، على حساب أدائهم وقضيتهم مع خصومهم الأساسيين. ويبدو أنّ أيّ تجاوز لحال سوريا والسوريين لن يكون ممكناً إلّا بتنظيم طاقات البحث والحفر والعمل المنوّع الأشكال، وعزل أشكال الخطاب المذكورة وتجليّاتها، في خطب الخطباء أو شفوية الشعبويين وعقليتهم القائمة على التسطيح والابتزاز… والأكشن!
مجلة أوراق