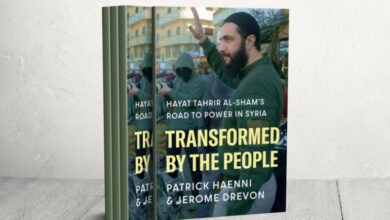متاهة الأوجه الكثيرة للحكاية ذاتها/ عمار المأمون

كيف نناقش كتاباً عنوانه يبدأ بقسم مفاده أن شخص ما، سمع حكاية ما، ونسبها لنفسه. نحن أمام تأكيدين، الأول ربانيّ، مُتمثل بالقسم، ويكتسب سلطته من قوة عُلويّة، والثاني شخصي نابع من معرفة الشخص ذاته وحكمه الذاتي على ما يسمع، أي لا نستطيع أن ننعت أحدهم بالكذب مشككين بقسمه، إن كنا بالأصل لا نعرف حكايته، فهذا الشخص يمتلك صلاحية نسب ما سمعه لسيرته، دون أن يكون لرأينا أي تأثير.
يبدأ الالتباس السابق من غلاف الرواية الجديدة للمغربي عبد الفتاح كيليطو: والله إن هذه الحكاية لحكايتي، القسم الذي تردد سابقاً في كتب كيليطو حين حديثه عن شهريار، واكتشافه نهايةً أن شهرزاد تقص عليه حكايتـ(ـه) طوال الليالي الألف، نقرأ المعلومة السابقة مرة أخرى على الغلاف الخلفي للكتاب، ذاك الذي لم تُهمله النسخة الإلكترونية، فـ«كل» مكونات الكتاب المادية واللامادية مُهمة حين الحديث عن صاحب «لسان آدم».
تزداد الحيرة «والمتعة» كلما تقدما أكثر في الصفحات، لتتحول إلى نوع من الفصام، إذ يشكك القارئ أولاً بذاته وما يعرفه، ثم بالكاتب وما يدّعي أنه يعرفه، هذا إن لم يحاول القارئ تفسير اقتباس البداية المنسوب لفرانز كافكا، و ربط عناوين الفصول لإيجاد العلاقات السرديّة بينها، والسبب، أن كيليطو يدسّ فيما يكتب الكثير من الحكايات المبتدعة، والفرضيات والأبحاث العلمية التي «نظنّها» حقيقة، كالدراسة التي تتحدث عن «النوم» لدى شهريار، وكيف أن الأخير مصاب بالأرق، بالتالي، اللا يقين قائمٌ دوماً حين نقرأ، ترسخه علامة تجنيس «رواية» التي تعتلي الغلاف، أي اختصاراً للحذلقة، كل ما نقرأه في هذا الكتاب، محض تخييل، هكذا يدلل الحَذِرُ قراءته حين يباشر بكليطو مفترضاً أن نسخ الكتب التي تظهر في الرواية لا تتطابق مع تلك الموجودة في مكتبته أو قرصه الصلب.
نقرأ، نتذكر، نقرأ أكثر، ثم ننسى، ثم نؤلف ما لم نقرأه، هذه التقنية يفعلها صاحب «لن تتكلم لغتي» الذي لطالما راوده حلم عن تأليف ليلة جديدة تضاف إلى «الليالي»، والمقصود ألف ليلة وليلة، و هذا ما يخطر على البال حين نبدأ بالصفحة الأولى، حين تقرر نورا، زوجة حسن ، أن ترتدي زيها المصنوع من الريش، وتحلق عالياً مع طفليها، بينما يتأمل زوجها المشهد خائباً وغاضباً.
هذه الحكاية التي ينفصل الراوي عنها فوراً، ويبدأ بمحاولة فهم أصلها ستتكرر طوال الكتاب، مع الحفاظ على مكوناتها: «امرأة جميلة تخطف لب أحدهم، أم في المطبخ، لوحة ، صديقة وفية للزوج، حلم، كتاب منسي أو لم يجرؤ أحد على قراءته»، هذا التكرار يظهر مرة على شكل خرافة، ومرة على شكل منمنمة، ومرة أخرى بشكل قصة حب في باريس، وأخرى في الشمال الأوروبي البارد، وبالطبع الأستاذ «ع» أو كيليطو المتخيّل، يظهر كساخر في الحكاية، شخصية هامشية لا تلعب دوراً مفصلياً ولا تفعل شيئاً سوى الهزل، هو قارئ تتغير أحواله دون أن يتدخل، يكتفي فقط بالتعليقات و التمتمة مع فتاة لا نعرف اسمها.
اليقين الأول «وربما الوحيد» الذي نصل إليه أن قصة حسن البصري موجودة في الليالي، أي ليست هي الحكاية التي يرغب كيليطو بدسّها، إذ نراه يعلق عليها ويسخر من بعض مكوناتها، إذاً الإشكالية ليست فيما قَرأ، بل في ما لم يقرأه، فيما أُهمل وتم تفاديه، ويتضح هذا حين الحديث عن كتاب «مثالب الوزيرين» لأبو حيان التوحيدي، فعلى طول الرواية نقرأ جهود حسن ميرو والمختصين في التوحيدي الرامية إلى تفادي قراءة هذا الكتاب الملعون، ذاك الذي لم يجلب سوى الأسى لكل من اقتناه ناهيك عن قراءته، هذه اللعنة التي تبدو كإشاعة، نكتشف أن من بدأها ابن خلكان في وفياته، حيث وصف مصير من يقرأ هذا الكتاب و نهى الناس عن قراءته.
نتعلم من الحكايات التي تتقاطع جهود تفادي القراءة، إذ نتعرف على التقنيات التي يمكن أن يتبعها أحدهم كي لا يقرأ كتاباً، كجمع المقتطفات والاقتباسات من كتب أخرى، و محاولة قراءته بلغة ثانية، أو الاستماع إلى أحدهم وهو يقرأه، هذه التقنيات حاول طالب الدكتوراة حسن ميرو أن يطبقها قبل أن يناقش رسالة الدكتوراة، دون أن يقرأ هذا الكتاب الذي يشكل جزءاً منها، و هنا، نعود للعنوان: «هذه الحكاية..»، حكاية من بدقة؟ من هذا الذي تفادى الكتب ولم يقرأها وحاول التحذلق حولها؟ الأستاذ «ع» ؟ ربما.
هناك سخرية حاضرة دوماً لدى كيليطو من الأكاديميّة، ورسائل الدكتوراة وفرضياتها، إذ يخبرنا عن رسالة دكتوراة تتمحور حول «المُربي» في رواية التربية العاطفية لفلوبير، واقتراح لأخرى تتبنى حكاية لا نستطيع التأكد من صحتها، حول توفيق الحكيم، و كيف كان يسرق السكر من طاولات المقاهي التي كان يرتادها في باريس ويضعه في جيبه، هذا التهكم من «دقة الاختصاص»، يقابله الموسوعية التي يكتب بها كيليطو الذي يتحرك بين لغتين وتاريخين، متنقلاً بين مئات الكتب، تلك التي قرأها والتي لم يقرأها. تتعمق السخريّة لدى الحديث عن الأبحاث المقارنة، كحالة مقاربة التوحيدي بمونطيني، ووفيات الأعلام بكتاب العزيف أو نيكرونوميكون. هذه المفارقات الساخرة تعتمد النموذج الأوروبي وتقارن عبره «أدب لآخرين»، هذه القضية يثيرها كيليطو بوضوح في هذه الرواية وما سبقها من كتب، فمثلاً كيف يمكن أن نترجم لأي لغة – دون أن نقهقه – المطلع التالي : «أَعَزُ مكانٍ فِي الدُنيا سَرجُ سَابِحٍ» (the most honorable place in the universe is the saddle of a horse)؟ كيف يمكن أن تظهر المفارقة اللغويّة بين «أعزُ» و «الدنيا»؟
المثير للاهتمام أيضاً، أن الكتب المذكورة في الرواية حقيقة كانت أم ضائعة أم متخيلة، التي تتناول «أشخاصاً» هي إما مدح أو تقريظ أو اختزال لسيرة أحدهم، وكأن كيليطو يحاول أن يجد لنفسه «مُلخصاً» يلصق أمام اسمه حين الحديث عنه سواء كان حياً أو ميتاً، فسخريته من نفسه في الرواية لا تندرج تحت هذا التوصيف، خصوصاً أن الرواية لا تحوي تعريفاً بالمؤلف، تلك السطور القصيرة التي تصف «صاحب» الكتاب أو مؤلفه.
هنا نتساءل، إن أردنا إنجاز أنطولوجيا عن الكتاب العرب الذين يكتبون بالفرنسية والعربية، كيف نصف كيليطو، هل نذكر شبابه وطفولته، تلك التي يخبرنا في كتاب سابق أن كتاب السير يهملونها، أم هل نكتفي بكلمة «كاتب»؟ وهل يمكن القول إن له مؤلفات يمكن تعدادها؟ خصوصاً أن مطلع الرواية هو التالي «يحدث هذا، مرّة أخرى، في بيت والديّ..» أي هذه الحكاية مذكورة سابقاً، أو حدثت في مكان/كتاب ما قبل أن نقرأها، برأينا المتبذل، يمكن أن نكتفي بالتالي: «عبد الفتاح كيليطو: نَسّاء يتحدث العربية والفرنسيّة أعاد سرد ذات القصة المُتخيلة مراراً».
موقع الجمهورية