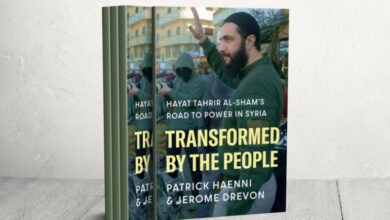الخبز وبريطانيا في سوريا الأربعينيات: قراءة أخرى للسلطوية/ محمد تركي الربيعو

على مدار العقود الأخيرة، بقي هناك سؤال يشغل قسماً من الباحثين في تاريخ سوريا المعاصر، ويتمثل في أسباب وجذور التسلط في هذا البلد. وعلى الرغم من أن البعض وجد أن الإجابة قد تكون بديهية وواضحة للعيان، فالجنرال الأسد ومماليكه الجدد، كانوا قد احتلوا البلاد بعيد السبعينيات، وهو ما سمح وفقا لميشيل سورا مثلا بتشكيل عصبية طائفية تمكنت من ضبط البلاد، ومن قمع أي حراك أو مطالب سياسية أخرى، ووفقا لهذا التحليل، فإن سوريا وعلى الرغم مما عرفته من تقلبات سياسية وانقلابات في فترة الخمسينيات والستينيات، فإن التحول السلطوي بدأ فعلاً مع قدوم حافظ الأسد.
في مقابل هذا التحليل، هناك من وجد من المؤرخين والباحثين في الاقتصاد السياسي،
أن ربط وجود التسلطية في سوريا بشبكة من الصفوة المتسمة بالشخصنة والمحسوبيات والطائفة، تبقى قراءة غير كافية، وأن أسلوب الحكم هذا لم يأتِ من العدم، بل سبقته ترتيبات سياسية ومؤسساتية، أسست لعلاقات جديدة بين المجتمع والدولة في سوريا، وأتاحت الفرصة لتأسيس نظام تسلطي صلب في البلاد.
وكان المؤرخ السوري الفرنسي زهير غزال، أو بالأحرى المؤرخ المجهول في بلاده، قد ذهب إلى هذه النتيجة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، من خلال كتابه الأساسي» الاقتصاد السياسي لدمشق في القرن التاسع عشر» الذي وجد فيه أن دمشق قبل 1839 غير دمشق اللاحقة، على مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع. فقبل فترة التنظيمات، يلاحظ غزال أن المجتمع المحلي حافظ على نوع من الاستقلال خاص به إزاء السلطة، وعند حدوث نزاع كبير، كانت الدولة تتدخل لفرض ضرائب جديدة على سبيل المثال، أو لقمع بعض الأحداث، في حين كان المجتمع يدافع عن نفسه إزاء هذه التطورات، من خلال التحالفات المحلية المؤقتة. لكن مع ظهور عصر الإصلاحات، توجهت السلطات العثمانية نحو إدخال تعديلات ساهمت في مركزة الدولة ووجودها بشكل أوسع في الحياة العامة، كما عملت هذه السلطات على صناعة نخبها المحلية، بدلاً من أن تكون وليدة البيئات المحلية إلى حد ما، لكن هذا التحول لم يظهر إلا بعد الستينيات في القرن التاسع عشر في دمشق، فقد بقي المجتمع الدمشقي في رأيه يرفض التعديلات الحكومية تحسباً من نتائجها، ولذلك استمر الأمر بين شد ورخو إلى أن قامت الفتنة في دمشق عام 1860، ما أفسح الفرصة أمام السلطة العثمانية لفرض سياساتها المركزية على المدينة.
وربما من خلال هذه القراءة، نجد أن بدايات تشكل السلطة المركزية، ظهرت في سوريا منذ نهاية القرن التاسع عشر، قبل أن تفرض بأساليب أوسع في الستينيات والسبعينيات في القرن العشرين. وفي مقابل قراءة غزال، هناك من ذهب إلى أن التشكل الأساسي للسلطوية في سوريا، جرى بعيد الخمسينيات، وبالأخص خلال الفترة الممتدة بين 1958 و1970، وهو ما كان محل نقاش ستيفن هايدمان في كتابه «السلطوية في سوريا» الذي وجد فيه أن بدايات التسلط الفعلي في البلاد ظهرت مع أساليب عبد الناصر وقراراته على مستوى الزراعة والصناعة، خلال الوحدة مع مصر، وأن هذه الإجراءات، مثلت اللبنة الأولى لهذا التحول التسلطي، سواء من خلال تغول الدولة أكثر فأكثر في الحياة العامة، أو حتى على مستوى أساليب العنف التي مورست لاحقاً، والتي تعلمها الضباط السوريون كما يرى هايدمان، وبالأخص ضباط وزارة الداخلية، من خلال احتكاكهم بالضباط المصريين؛ ومع الانفصال، الذي لعب البورجوازيون دوراً فيه، وجد البعثيون أن «التسلط الناعم» الذي مارسه عبد الناصر لم يكن كافياً، ولذلك اندفعوا بعيد 1963 في ظل المعارضة لهم من قبل رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، إلى فرض تسلطية شعبوية، ما أتاح لحافظ الأسد ووريثه لاحقاً، الاستمرار في ظل حكومة مركزية صلبة، لا تتيح الفرصة لظهور منافسين محليين.
الطعام والحرب العالمية الثانية
ومن بين المقاربات الجديدة في هذا السياق، ما ذهب إليه مؤخراً محمد علي الصالح، الباحث والمؤرخ في الاقتصاد السياسي لدمشق، خلال فترة الانتداب الفرنسي في كتابه الصادر قبل أيام عن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بعنوان «إدارة الاقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي 1918/1946 تأثيراتها فيما بعد الاستقلال» إذ يرى أن فكرة الدولتة في سوريا (بمعنى التحكم في الاقتصاد والمجتمع) بدأت تتبلور خلال فترة الوجود الفرنسي للبلاد، وهنا لا بد قبل المضي في طرحه، من الإشارة إلى أن ربط المؤلف بين «الدولتة» والفرنسيين في سوريا لا يأتي في سياق تحليلات مدرسة ما بعد الكولونيالية، والتي عادت ما حملت المستعمر سبب فشل الدول الحديثة، وهو ما ذهبت إليه مؤخراً اليزابيت تومبسون في سياق قراءتها لفشل التجربة الديمقراطية في سوريا، عبر ربطها بالتدخلات الأجنبية، في حين يذهب الكتاب في قراءته للمسألة هنا من جانب اقتصادي، ومن أن ما حدث في هذه الفترة المدروسة، كان بالإمكان تجنبه لاحقاً من قبل النخب الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال.
وربما الجديد في طرح المؤلف، هو أنه يرد تغول الدولة في الحياة العامة السورية بوصفه غير ناجم عن السياسات الانتدابية الفرنسية، وإنما هو وليد السياسات البريطانية/ الأمريكية في سوريا مع قدوم الحرب العالمية الثانية في عام 1939.
يرى صالح أن فرنسا لم يكن لها مشروع جدي لتأسيس دولة في سوريا، ولذلك اكتفت خلال السنوات الخمس الأولى من الانتداب بتعيين جنرالات عسكريين لإدارة البلاد، وتركهم يديرونها بعقلية عسكرية، من خلال تقسيمها إلى دويلات، ما أدى إلى أن يغدو الصدام مع أهل البلد واردا لا محالة، كما جرى في عام 1925. لاحقاً وبعد هذه الأحداث، شهدت باريس رؤية أخرى حول إدارة سوريا، التي عبرت عنها مرحلة هنري دو جوفنيل، الذي وجد أن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون أكثر ملاءمة للطرفين، وأن استقرار الأوضاع سياسيا في سوريا يتطلب تطوير أرضية اقتصادية وخلق إصلاحات ومؤسسات أكثر تمثيلاً وعملاً، مع ذلك لن يكتب لهذه الرؤية النجاح مع قدوم ريمون بوانكاريه المحافظ رئيسا للوزراء، الذي رفض هذه الإصلاحات في ظل الأزمة التي كانت تعيشها بلاده، ليعود النهج التقليدي ذاته في حكم سوريا إلى عام 1933، ما نجمت عنه آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، ففي الشمال، حوصر الناس في منطقة حلب، ومنعوا من التواصل مع امتدادهم الجغرافي في هضبة الأناضول، كما منعت دمشق وأهلها من التواصل مع سواحل فلسطين، كما أن 37.5% من الميزانية الفرنسية في سوريا بقيت تنفق على الأمن، وهو ما فاق الإنفاق البريطاني في العراق (29.89%) أو فلسطين (17.6%) ويلاحظ المؤلف من خلال الأرقام والإحصائيات وتتبع سياسات الفرنسيين الإقراضية الزراعية، أنهم لجؤوا أحياناً لإجراءات عثمانية قديمة، ولم يطورا في أساليبهم كثيرا، ناهيك من قلة اهتمامهم بالتعليم (9% من مجموع الإنفاق العام) والصحة (3%).
لكن سوريا ستشهد تطورا جديداً مع قدوم الحرب العالمية الثانية، التي فرضت معطيات جديدة على دول الحلفاء، كان أهمها كيفية تأمين الطعام في ظل ازدياد الطلب عليه، ضمن البلاد التي اشتعلت فيها الحرب، وأيضا دول المشرق، التي وإن لم تشارك في الحرب إلا اسميا، إلا أنها شاهدت الآخرين يقتتلون على أراضيها، وفي ظل هذه الظروف المستجدة، قام البريطانيون والأمريكيون في نيسان/إبريل عام 1941 بإنشاء هيئة للتموين والإمداد دعوها «مركز التموين للشرق الأوسط» وقد لعبت في البداية دور الاستشاري، ولاحقاً أتيح لهذا المركز لعب دور في تنظيم اقتصاد الحرب للحلفاء، بهدف سد حاجات قواتهم المحاربة من الطعام، وأيضا لدرء أي تهديد لخطوطهم الخلفية، يمكن أن يحدث جراء احتمال انتشار المجاعة في وسط بشري معاد لهم أصلا، ومستعد لتقبل دعايات دول المحول لينتفض ضد الحلفاء. وقد عرف القائمون على نشاطات هذا المركز بقناعاتهم، بأن الدولة تشكل عموما عاملا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن عليها أن توفر الأمن الاجتماعي للبشر الذين يخضعون لها، ما يخدم في نهاية الأمر مجهودهم الحربي. وانطلاقاً من هذه الخلفية، سيتدخل مركز التموين في سوريا، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي بعد غزو ألمانيا لباريس، بداية من خلال إنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، وأيضا عبر ضبط أثمانها، وهكذا كان المركز حسب الدكتور الصالح يعمل عن غير قصد على التأطير لمنظور آخر حول دور الدولة (الدور الموجه) كعامل بديل لإرساء ونشر العدالة، وحل التناقضات الاجتماعية، دون الحاجة للمرور أولا عبر النخب البورجوازية، كما في نظام اقتصاد السوق الحر، الذي اعتمدته السلطات الانتدابية الفرنسية، ولذلك قام عام1942 بتأسيس «مكتب الحبوب الصالحة للخبز» بإدارة فرنسية وبريطانية مشتركة، للحد من الاحتكار والمضاربة، ومنع تخزين القمح، وعدم حجبها عن الأسواق عشوائيا. كما عمل مركز الإمداد في القاهرة أيضا على تزويد سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بجملة من المؤسسات الاقتصادية، كالمكتب الصيدلاني لسوريا ولبنان، وغيرها من المؤسسات، كما ساعد في إعادة تنشيط عمل الإدارات الحكومية القائمة فيهما، من أجل تسخيرها هي أيضا، لدعم المجهود الحربي للحلفاء، وبذلك كان هذا المركز قد شكل مثالاً مهماً في كيفية الإدارة المركزية للاقتصاد بفاعلية كبيرة، وهو ما ستكون له تداعيات لاحقاً بعد انتهاء الحرب، إذ اختارت النخب السورية بعد استقلالها، خلافاً للنخب اللبنانية، الاستمرار في هذا الرؤية (الدولة الموجهة).
واللافت هنا، أنه على الرغم من أن الحلفاء كانوا يعتبرون مشروعهم محدودا زمنيا، ومرحليا، ولذلك، نراهم يدون تخوفهم من احتمال استمراره إلى ما بعد انتهاء الحرب في بلدان المنطقة. ففي المؤتمر الذي عقده «مركز التموين للشرق الأوسط» في القاهرة في آب/أغسطس1943، لمناقشة مشاكل توزيع وتقنين المواد الغذائية، تجسد تخوفهم من أن يحدث ذلك فعلا. وعندما شارفت الحرب على نهايتها، بدأت الضغوط من جهات عدة على السلطة الوطنية في سوريا، للتخلي عن سياسة الضبط الاقتصادي، مع ذلك يلاحظ الدكتور الصالح، أن هذه النخب ظلت مصرة على موقفها أو رؤيتها المؤيدة لتدخل الدولة، وهو ما يرده إلى أنها وجدت في أسلوب التدخل ما يضمن لها السيطرة على البلاد، كما أن بعض التيارات السياسية في تلك الفترة مثل الشيوعيين أيدت تدخلاً أوسع للدولة، وبذلك نلاحظ أن المتطلبات الاقتصادية والإدارية التي ولدتها الحرب العالمية الثانية، كانت لها تأثيرات محسوسة على عملية تشكل جذور الدولتة (السلطوية) في سوريا، وفي إيجاد آليات أخرى لضبط علاقة الدولة بالمجتمع والاقتصاد.
كاتب سوري
القدس العربي