في ضرورة تفكيك “الإسلام”/ ماهر مسعود
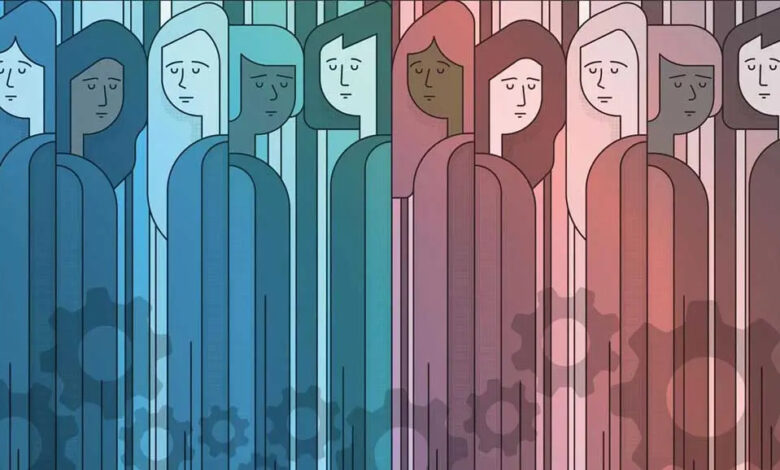
كثيرًا ما نكره الغباء الذي يختزلنا كأفراد، وينزع عنّا الفرادة لكي يضعنا في مجموعات كتلوية كبيرة ونمطية، ثم يدفعنا إلى تبنّيها، فأن يتم اختزالك إلى مُسلم في أميركا، أو عربي في أوروبا، أو سوري في لبنان، أو سنّي/ درزي/ مسيحي… في سورية، هو -في أحد أوجهه- نزعٌ لإنسانيتك كفرد، ولفرديتك كإنسان، وهو طريقة تسهّل على من يضعك في تلك الخانات الكبرى شيطنتك، التي قد تصل إلى حدود الدعوة لقتلك، أو تقديسك؛ التغاضي عن خطاياك، التقليل من شأنك تمامًا، أو الإعلاء من شأنك كثيرًا، بما هو في كلا الحالين اختزال بغيض لما هو أنت.
كان من نتائج الحرب على الإرهاب اختزال الإرهاب للدلالة على “الإسلام”، ولم يكن هناك أوضح من دونالد ترامب في هذا السياق، عندما أعلن نيته القضاء على “الإرهاب الإسلامي”، حيث تحوّلت علاقة الإسلام بالإرهاب اليوم إلى علاقة تبادل حصري، وبات الإسلام والإرهاب صنوان يدلان على معنى واحد، إن صح التعبير، فبشكل لا شعوري، لن يمكنك السماع عن عملية إرهابية في أي مكان بالعالم من دون أن يخطر في ذهنك أنها عملية إرهابية إسلامية، وحين تعرف بعد دقيقة أنّ العملية لم تكن إسلامية، ستشعر بالسعادة، وتشكر الله على أنها ليست إسلامية؛ وبالتالي ليست إرهابية، ثم تتابع نهارك بنوع من راحة الضمير، أو الأمان الناتج عن كونها عملية عادية، لشخص مريض نفسي، أو متعصب قومي ما، لكنك بالتأكيد لن تهتم بالضحايا ولا بالقتل نفسه، بالطريقة ذاتها، حين تكون العملية إسلامية، ولن تذهب تحليلاتك إلى أبعد من التأفف والمضيّ قدمًا، وكأن شيئًا لم يكن.
لكن السؤال المركّب الذي يجب طرحه هنا هو: هل يختلف أيّ منّا عن دونالد ترامب، عند الحديث عن “الإسلام”، بل هل يختلف الإسلامي عن أيّ منّا عند حديثه عن “الإسلام”! وبكلام آخر، هل هناك شيء يسمى إسلام، أو “الإسلام” بأل ولام التعريف؟ الجواب الأول هو نعم، هناك إسلام ظهر في التاريخ في القرن السابع الميلادي وانتهى بموت رسوله، ولكن هذا يقودنا إلى الجواب الثاني، وهو لا، لا يوجد إسلام بذلك المعنى الكلّي، فمنذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا، لا يوجد إسلام، بل يوجد “إسلامات” بالجمع، ويوجد مسلمون، وأما التنوع الهائل، الأفقي والعمودي، لأشكال الإسلام، فلا يمكن حصره. حيث إن الإسلام قبل خمسين سنة ليس هو ذاته قبل مئة سنة، ولا هو ذاته قبل ألف سنة، ليس هو ذاته في شبه الجزيرة، كما بلاد الشام، أو بلاد الفرس، أو الهند وإندونيسيا والصين.. إلخ، بل إنه لا الإسلام ولا المسلمون في بلد واحد هم كتلة غير متجانسة، فبعيدًا عن كون المسلمين في سورية، مثلًا لا حصرًا، هم تنويعات عقائدية وطوائف، فيها السني والشيعي والدرزي والعلوي، وتنويعات اثنية مختلفة، فيها الكردي والشركسي واليزيدي.. إلخ، فإن السنّة وحدهم في دمشق غيرهم في حلب أو درعا، وفي دير الزور غيرهم في إدلب أو السويداء.. بل إنك ستجد في المحافظة الواحدة إسلامًا ريفيًا وإسلامًا مدينيًا، إسلام طبقة وسطى، وإسلامًا شعبيًا، وإسلام نخبة، ستجد مسلمين مؤمنين ومسلمين ملحدين.. إلخ. كل هذا التنوع والتشعّب والتعدد، ثم يأتينا الأسد أو أدونيس أو زهران علوش، ليخبرونا أن الثورة إسلامية سنيّة، ويأتينا لافروف ليرفض حكم السنّة في سورية، ثم دونالد ترامب ليخبرنا بعزمه على هزيمة “الإرهاب الإسلامي” ومحوه من العالم!
في الواقع، لا يقتصر الأمر على السياسة، بل إن السمة العامة للمستشرقين أو الباحثين العرب في القضايا الإسلامية، هي أن معظمهم ما زال يُسهم معرفيًا ويؤسس إبستمولوجيًا لوضع الإسلام ضمن رواية كبرى أو “Grand narrative”، ويتعاملون مع الإسلام مثلما يتعامل أقرانهم مع العصور الوسطى المسيحية، فأن تتكلم كباحث أو كسياسي اليوم في القرن الحادي والعشرين عن “المسيحية” المعاصرة بشكل عام أو المسيحيين في كل مكان، فإن ذلك سيجعل كلامك بلا معنى، ولا أحد سيأخذه على محمل الجد، فلم تعد تُعرَّف الدول الغربية “المسيحية” ولا مجتمعاتها ولا أفرادها بأديانهم، وبات اللاوعي الجمعي، داخل الغرب أو خارجه، غير قادر على اختزال الأفراد أو المجتمعات هناك إلى دينهم “المسيحي”، وإذا حصلت عملية إرهابية ما هناك بدوافع دينية، فلن يتمكن أحد من تسميتها “إرهاب مسيحي”، لأن كلامه سيبدو فعليًا بلا معنى.
كثيرًا ما تكون نظرة المستشرق أو الباحث العربي، في هذه النقطة بالتحديد، غير مختلفة عن نظرة المسلم العادي أو الفقيه أو شيخ الجامع للإسلام، بمعنى أن هناك إسلامًا جوهريًا “أصيلًا” ومتعاليًا، في مكان ما، تفرعت منه فروع عدة تماثل الأصل وتشبهه في نقاط ما، ولكنها لا تعبّر عنه تمامًا، وضمن هذا “الايبستم المعرفي” السائد، هناك صورة جوهرية معينة للإسلام تقوم على نفي ما عداها، وتلك الصورة تجعل إسلام (داعش) ليس هو الإسلام بالنسبة إلى إخواني، و إسلام الإخوان لا يعبّر عن الإسلام، بالنسبة إلى صوفي أو سلفي.. أو أو إلخ. وبالتالي سيتم نفي الإسلام عن كل شخص وفئة وجماعة، لأنه لا أحد في محصلة هذا النوع من التفكير سيمثّل “الإسلام الحقيقي” حتى المتكلم نفسه. في الواقع، ليس هناك على الإطلاق “إسلام حقيقي”، وفي الوقت ذاته، كلّ إسلام هو إسلام حقيقي، حيث إنه، مرة أخرى، لا يوجد “إسلام” بل إسلامات، وكل نسخة أو “Version” من هذه الإسلامات المتنوعة والمختلفة جدًا هي إسلام حقيقي.
عبر ضرب وتحطيم تلك المركزية والصورة الجوهرية المتعالية للإسلام، فإننا نمضي أولًا نحو التعبير عن الواقع الفعلي للمسلمين، على تنوعاته واختلافاته، ونمضي ثانيًا باتجاه التخلص من العنصرية الهائلة، الخارجية والداخلية والبينية، ضد المسلمين وفيما بينهم، فإن كانت قوى السلطة في “الغرب” توّحد المسلمين بطريقة عنصرية مع إسلام “متخلّف وإرهابي”، فإن قوى السلطة والمجتمع في العالم الإسلامي تفعل الشيء ذاته، مع كل ما هو ليس منها على المستوى المحلي، هذا ما يفعله السنّة مع الشيعة والعكس، وهذا ما يفعله وهّابي مع إخواني، أو إخواني مع سلفي، أو سلفي مع صوفي، ولكن أيضًا ما يفعله إسلام مديني مع ريفي، أو عربي مع كردي أو تركي.. الخ.
لا تحتاج العنصرية إلى أحداث كبرى وأمثلة عالمية، مثل مثال دونالد ترامب السابق، بل يمكن رؤيتها في أصغر التفاصيل والجزئيات، فأن تخبر شيخًا سلفيًا بأن إسلامه ليس أفضل من إسلام شيخ صوفي، فإن ذلك سيشعره بالإهانة وقلّة القيمة، ولن يقبل أبدًا بمساواته مع غيره، وعلينا أن نتذكر هنا أن معظم من قتلهم تنظيم الدولة (داعش) كانوا مسلمين، تمّ النظر إلى إسلامهم كخيانة للإسلام “المسطرة” أو النموذج الذي حكم التنظيم باعتباره نموذجًا أعلى للإسلام والمسلمين، ولكن هذا لا ينطبق فقط على داعش، بل على كل نوع من الإسلامات الكثيرة جدًا، والتي تعرّف نفسها عبر إقصاء غيرها خارج حدود “الإسلام” الصحيح. وما يتم من إقصاء، وقد يصل إلى إباحة الدم، لا يقتصر فقط على الإسلامات التي تحتكم إلى منهج التمثيل والنموذج المتعالي، بل يتجه نحو رؤية العلمانيين العرب إلى الإسلام والمسلمين أيضًا، فغالبًا ما تجد هؤلاء يعاملون الإخواني بوصفه “وردة” داعشية، لم تتفتح كامل “أزهارها” الإرهابية بعد.
إن تأثير المنهج التمثيلي “representative method” في رؤية الإسلام، باعتباره جوهرًا أصيلًا ومتعاليًا تتفرّع عنه النسخ الناقصة الساعية لتمثيله دون أن تصل، بدلًا من كونه إسلامات متباينة كليًا وواقعيًا، ترك تأثيرات هائلة في سياق الثورة السورية، بحيث لم يكن أكثر خداعًا أو وهمًا -اجتماعيًا سياسيًا وفكريًا- في سورية مثل التوهم بأن السنّة السوريين هم أكثرية. وهو وهم مضاعف؛ وهم تجاههم، ووهم من قبلهم، فالحس الطبيعي العددي سيخبرك بأنهم فعلًا أكثرية، ولكن الواقع الفعلي، هو أنهم لم يكونوا أكثرية على الإطلاق، حتى عندما كان رئيس الجمهورية سنّيًا، ويكفي أن ندرك حجم النزاعات التي شدّت الحزب الوطني “الشامي” إلى مصر، وحزب الشعب “الحلبي” إلى العراق، لكي ندرك مدى تأثير ذلك على مستقبل سورية ونهايتها البعثية. لكن الأكثر صلة بموضوعنا هنا هو أن السنّة لم يكونوا أكثرية في ظل الأسدين على الإطلاق، بل أقليات متنافرة ومختلفة ومتباعدة، مثل جميع السوريين من غير العلويين، فالعلويون كانوا هم الأكثرية، حتى لو كان معظمهم معارضين أو من ضحايا السلطة الأسدية ذاتها، لأن ما يحدد معنى أي أكثرية هو السلطة التي تخلق المعايير العامة للمجتمع، والمعيار العام للمجتمع في سورية كان علويًا، الحديث بالقاف هو معيار أعلى، المراكز الحساسة في الدولة ومؤسساتها كانت وما زالت علوية، حتى لو كان من يشغرها سنّيًا مثلًا، فهو لن يشغرها حتى يكون متماهيًا بالكامل مع السلطة “العلوية”، ولكن تلك الأكثرية العلوية لم تكن أكثرية بوصفها دينًا أو طائفة دينية، بل بوصفها علوية سياسية. والعلوية السياسية هي مثل الجسد بلا أعضاء، عند جيل دولوز، استبدلت كل علوي واقعي بآخر رمزي، يرمز للسلطة، وبالتالي فإن ما فعله حافظ الأسد هو إلغاء جميع العلويين الواقعيين، المختلفين جدًا، برمز واحد هو السلطة التي يملكها هو وعائلته. ولذلك قلنا، في وقت سابق، وفي مكان آخر، إن تحرير السلطة من الأسد هو تحرير العلويين أنفسهم من وهم السلطة التي كبّلهم بها الأسد خلال نصف قرن. ولكن ليس ذلك لتسليم الرئاسة إلى “سنّي” بالضرورة، بل إلى مواطن سوري غير علوي بالضرورة، أي لا يمثّل الرمز الذي السلطوي الذي صنعته السلطة الأسدية.
إن تفكيك “الإسلام”، بوصفه وعيًا بكلانية غير موجودة في الواقع، هو أولًا اعتراف بالتنوع الهائل للإسلامات والمسلمين الموجودين والمختلفين إلى حدود التناقض، وهو ثانيًا تحرير للمسلمين؛ أفرادًا وجماعات، من العنصرية التي يمارسونها وتُمارس عليهم، وتحريرهم من الاختزال الذي يجمعهم في كتل كبرى دون تفاضل أو تفاصل. وهو أخيرًا بناء لوعي ذاتي و”غيري”، يقوم على الاختلاف والاعتراف بدلًا من دمج الملايين من الناس وحشرهم في هوية ثابتة وجوهرية غير موجودة، ولا تسهم فعليًا إلا في تشريع الحروب البينية بينهم، وتشريع الحرب عليهم، تحت مسمّى شنيع وعنصري هو ذاته، أي “الإرهاب الإسلامي”.
مركز حرمون




