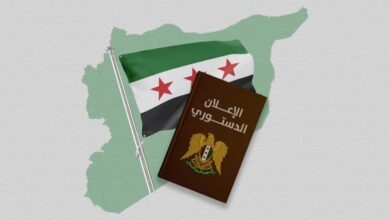مقالان تناولا تشكيل المجلس العسكري

————————————
نقاش مع مناف طلاس في المجلس العسكري/ سميرة المسالمة
مجدّداً، يؤكد العميد مناف طلاس (المنشق عن النظام السوري منذ عام 2012) أنّ الحلّ المتاح، وربما الوحيد في نظره القابل للتداول في الواقع السوري، تشكيل مجلس عسكري انتقالي، مهمته استعادة الاستقرار في سورية، ووضعها على عتبة التغيير السياسي. ومع أهمية الطرح الذي كان يمكن أن يكون متاحاً قبل سنوات عديدة، أي قبل تحول سورية إلى ساحة للصراع العسكري، بين النظام وفصائل مسلحة “محسوبة على المعارضة” ذات أجندات خارجية، كانت قد أزاحت فصائل الجيش الحر بذرة الثورة المسلحة، أو قبل تحولها إلى ساحة للتصارع على النفوذ بين أطراف دولية وإقليمية وبأذرع محلية على الجانبين، النظام والمعارضة.
وقبل مناقشة فكرة طلاس، في مشروعيتها أو جدواها، يجدر بي التأكيد أنه يُحسب للرجل، وهو العسكري، نأيه بنفسه عن النظام منذ اليوم الأول لتفجر الثورة السورية، بسبب معارضته الحلّ الأمني، ومحاولته، في مبادرةٍ شاركتُه فيها، بداية الثورة وقبل تحولاتها الاسمية والشكلية، فتح حوار مع المعارضة في بيتي في دمشق، لإيجاد مخرجٍ يحقق التغيير السياسي السلمي، الأمر الذي ما كان له أن يثمر بوجود قوى أمنية منتفعة من الحكم الأمني القمعي بذات درجة انتفاعها من انتشار الفوضى والاستثمار فيها في البلاد، ما حداه إلى مغادرة سورية.
إذاً، نحن إزاء فكرة تجد مشروعية تجديدها حلاً عند كل استعصاء معلن في الصراع السوري، ومن تحوّل البلد إلى ساحة متوزعة الولاء عسكرياً وسياسياً، وحال البؤس التي يعيشها السوريون في الداخل والخارج، لأسباب متفاوتة ومختلفة.
بيد أن المشروعية شيء، وهي، على أية حال، ليست مشروعية كاملة أو كافية، والمعقولية شيء آخر. ومثلاً، إذا كان هذا المجلس العسكري سيكون نتاج مقايضة أو تسوية بين النظام والمعارضة، كحال اللجنة الدستورية المشتركة، والمشكلة بقرار أممي في 23 سبتمبر/ أيلول 2019، فلا يوجد البتة ما يدعو إلى التفاؤل أو يؤيد ذلك بتجربة عشرة أعوام، وعشرات الجلسات التفاوضية، إذ لم يقدّم النظام أي شيء، بل ولم يعقد ولا جلسة واحدة جدّية مع وفود المعارضة، سواء في جنيف أو في أستانة أو في اللجنة الدستورية.
على ذلك، ما الجديد في هذه الدعوة، وإلى ماذا يستند طلاس في طرحه فكرته؟ الآن، على فرض أن النظام وافق على طرح كهذا فما هي القوة، أو من أين سيستمد المجلس العسكري المفترض قوته العسكرية، مع معرفتنا بطريقة عمل النظام، وأنه هو الوحيد الذي يمتلك القدرات والقوات العسكرية، ومع معرفتنا بهشاشة فصائل المعارضة وفوضويتها، وتوزع ولاءاتها؟
من ناحية أخرى، يبدو أن هذا الطرح يستند إلى الوهم ذاته الذي وقعت في إساره المعارضة، منذ عشرة أعوام، أن النظام الدولي سيجبر الأسد على التنازل، إلى هذه الدرجة أو تلك، لكن تلك مخاطرة أخرى، فليس في الأفق ما يشير إلى توجهٍ كهذا لدى الأطراف الخارجية لفرض أي نوع من الحلول لاستعادة الاستقرار إلى سورية، وبالأخص لا يوجد لدى الولايات المتحدة، وهي برأيي صاحبة القرار في هذا الشأن، أي توجّه في المدى المنظور لحسم الصراع في سورية. (يمكن مراجعة مقالتي في “العربي الجديد” “بين جمال سليمان ومناف طلاس” 15/2/2021).
في حال أخرى، أي في حال كان الطرح يتعلق بتشكيل مجلس انتقالي عسكري، كجهة معارضة، فهذا سيكون أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ لا توجد تشكيلاتٌ عسكرية، بمعنى الكلمة، للمعارضة، والفصائل الموجودة ضعيفة التنظيم والتسليح، ولمعظمها ولاءات خارجية (بخاصة لتركيا). وبالتالي، لن يُعتدّ بهذا المجلس شعبياً، ولن يشكّل خشبة خلاص، ولا سيما في تجارب السوريين مع فصائل المعارضة العسكرية، وضمنه تجربتها في الإدارة في ما عرف بـ “المناطق المحرّرة”. الأهم من ذلك كله أنه لا توجد أطراف دولية تدعم هذا الطرح، بشكل جدّي. وإذا ذهبنا إلى مقاربة تاريخية، مثلاً، فللأسف ليس لدينا ديغول سوري، يحظى، بسبب سمعته ومواقفه، بما حظي به ديغول من الفرنسيين، وليس لدى السوريين حلفاء، مثلما كان لدى الفرنسيين إبّان حكم بيتان (الموالي لألمانية النازية)، بل عانى الشعب السوري كثيراً جرّاء تنكر ما سمي معسكر الدول “الصديقة” له.
أما إذا أردنا مناقشة هذا الطرح في تجارب الربيع العربي، فسنجد أنه لا توجد تجربة تؤيده، ففي معظم البلدان التي شهدت الثورات آلت الأمور إلى هيئات عسكرية أخذت بلدانها إلى عكس اتجاهات التطور الديمقراطي.
أخيراً، يبني طلاس فرضيته، أو أطروحته، على فشل السياسيين، وهو محقّ في تلك الحيثية. لكن يفترض به أن يفحص أسباب الفشل تلك، لأنها هي ذاتها ستؤدي إلى فشل أي مجلسٍ من نوع آخر، سواء كان أصحابه بملابس عسكرية، أو بملابس أكاديمية، أو بملابس محامين، أو بملابس أطباء أو عمّال أو طلاب أو فلاحين، إذ يعود السبب الأساسي إلى حرمان الشعب السوري السياسة، والنشاط الحزبي، وحرمانه حرية الرأي. كذلك فإن من أسباب ذلك الفشل احتكار النظام القوة، وتشكيله وحدات عسكرية على عقيدة “سورية الأسد إلى الأبد”، أي عقيدة حماية النظام. وبالتأكيد، من ضمن تلك الأسباب ارتهان القوى المهيمنة في المعارضة للأجندات الخارجية. ما يعني أن الأَولى بالجنرال طلاس، وغيره، من سياسيين وأكاديميين ومهنيين وعسكريين، شدّ الهمم باتجاه إيجاد منبر يعبّر عن السوريين، عن آمالهم وطموحاتهم، لعزل أي كيانٍ يعبّر عن أية أجندات أو ارتهانات خارجية، منبر يرون فيه أنفسهم، ويغذّون فيه الأمل بغدٍ أفضل لهم ولبلدهم، ويتحدّث عن حلول واقعية ويتجاوز فكرة أن العسكر وحدهم مؤهلون وغيرهم لا، لأن المعارضة “الخارجية” جرّبت على قياس ذلك بنسب التأهيل والوطنية لنفسها فقط، وأبعدت كفاءاتٍ مدرّبة تحت ذريعة أنّهم بقايا نظام سابقاً، وقد اكتوينا جميعاً منها. ومع ما سبق، إن كان المجلس العسكري متاحاً تحت أيّ عنوان، لن يكون أسوأ مما هو الحال الآن.
العربي الجديد
———————————–
بمناسبة الحديث عن مجلس عسكري سوري/ راتب شعبو
لماذا يجوز الاعتقاد بأن إنقاذ سورية مرهون بتشكيل مجلس عسكري وليس بتشكيل مجلس طبي، مثلًا، أو مجلس من الصحفيين أو من المعلّمات والمعلمين أو من القضاة أو من كتاب الرواية… إلخ؟ لماذا تكون المهنة العسكرية، في بلادنا، مدخلًا إلى السياسة أكثر من أيّ مهنة أخرى، حتى المهن الأقرب إلى السياسة؟ من المنطقي الالتفات إلى أساتذة العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية… إلخ، لحلّ الأزمات التي تمرّ بها البلدان، فلماذا تتجه الأنظار إلى العسكريين لحل التعقيد السياسي؟ وما تفسير أن يلجأ سياسيون إلى “مجلس عسكري” يأملونه مدخلًا إلى حل “سياسي” في سورية؟ أين يكمن سرّ هذا الترابط أو التماهي الذي أصبح كأنه بداهة، بين العسكري والسياسي؟ لماذا يتقدم العسكري للدور السياسي ويعتبر أن مهنته العسكرية تجعله أكفأ من غيره لصنع السياسة؟
لا يكمن السرّ في قوة العسكر. من الطبيعي أن يكون العسكر أقوياء، هذا هو مبرر وجودهم أصلًا، فالجيش هو جهاز القوة في الدولة، ويحوز لذلك على نسبة كبيرة من الموازنة، لا ليكون قائدًا للدولة، بل ليكون قوة في يد من يقود الدولة، أي في يد السياسيين. يكمن السرّ بالأحرى في ضعف السياسة. حين تكون السياسة ضعيفة، فإنها تميل إلى الاستناد على أجهزة القوة. ضعف السياسة يميل بها إلى أن تصبح سياسة قوة، أي سياسة فرض وقسر وإكراه بالقوة. السياسة الضعيفة تستجلب العسكر إلى السياسة. قد يدخل العسكر إلى السياسة تلقائيًا، كأن ينقلب الجيش على طبقة سياسية فشلت في قوننة صراعاتها السياسية وضبطها، وتعثرت بالتالي في إدارة البلاد، وهكذا يصبح الجيش، ليس فقط قوة الدولة، بل عقلها المدبر أيضًا. ويمكن للجيش أن يدخل السياسة أيضًا بواسطة السياسيين الذين يسندون سياستهم بالجيش، كما حدث في تونس، باستناد قيس سعيد على الجيش والشرطة ضد الطبقة السياسية المنتخبة. ويمكن أن يكون الجيش أداة للانقلاب على تحوّل سياسي ما في البلد، بدعم من دول خارجية تستفيد من قوة الجيش وانضباطه الهرمي، ومن النزوع الغريزي عند الجيش للحكم، النزوع الذي يتوفر عادة عند كل من يستشعر القوة في نفسه.
يصبح من العسير إبعاد الجيش عن السياسة، حين يدخلها، لأنه لا يوجد في المجتمع قوة يمكنها مواجهة الجيش، إذا أراد الجيش مواجهة المجتمع. فكيف إذا كان للجيش، نتيجة تاريخ سياسي بائس في بلداننا، “جيش” من المرحبين بتدخله وإدارته “القوية” للدولة، وكيف إذا كان هذا الجيش قد حكم لعقود وجيّش الدولة وتغلغل في كل مفاصلها، وأنشأ له مؤسسات اقتصادية وخدمية مستقلة عن وزارة المالية (مصر، سورية، السودان…)، حتى بات يمكن لقائد عسكري سوداني انقلب أخيرًا على وثيقة دستورية سبق له أن وقعها مع المدنيين، أن يقول “الجيش هو الدولة”.
عقود من ضعف السياسة، أو قُل من غيابها، كرّست في الوعي العام تقديرًا للقوة على حساب السياسة. يحبذ الناس وجود رجل قوي يفصل في الأمور ويخضع له الجميع. حتى درج في الصحافة تعبير “الرجل القوي”، إشارة إلى من يمتلك القوة على فرض خياره. اعتاد الناس على هذا الحال الذي يبدو لهم “مطمئنًا” أكثر من مشهد صراعات قوى سياسية في البرلمان (قد يتحول الجدل البرلماني إلى عراك بالأيدي لغياب الرجل القوي)، وفي الصحف والإعلام والمواسم الانتخابية. لكن من الصعب، وربما من المستحيل، الجمع بين الرجل القوي والعدالة. فالعدالة لا تتحقق إلا بتحرير صراع المصالح في المجتمع، بضوابط قانونية وقضاء مستقل، بما يحقق توازنًا معقولًا بين مصالح الفئات والأطراف والتوجهات.
كل التشكيلات العسكرية التي نشأت في سورية على ضفة مقاومة نظام الأسد، كانت عسكرية سياسية معًا، أي لم تكن ذراعًا عسكريًا لقيادة سياسية. العسكري هو السياسي نفسه، لا توجد مسافة فاصلة بين المهنتين. تسري هذه الواقعة مسرى البديهيات. وفي عمق هذا الاعتقاد، نوع من الاحتقار الشعبي المتراكم للسياسة. في الوعي العام يبحث الناس عن حاكم عادل، وليس عن عدالة أو عن حكم عادل. الحاكم العادل رجل قوي “مستبد” يفترض أنه يحكم بالعدل، أما العدالة فهي آلية لإنتاج العدل، وهي تتعارض في العمق مع فكرة الرجل القوي.
الثقافة العامة، بما في ذلك ثقافة النخب السياسية، تستبطن تقديرًا وإعجابًا بالجيش، بقوته وانضباطه وصرامة التراتبية فيه، وهذا يلغي الصراعات ومظاهرها وصخبها، ويضع حدًا لتلكؤ السياسة وطول أمد استقرارها على قرار. أما العدالة فإنها لا تتحقق إلا في الصراع. ولا يمكن للجيش بقوته أو للرجل القوي أن يقيم العدل. العدل لا يمكن فرضه على الناس، إنه واقع يفرضه الناس في ما بينهم وعلى بعضهم البعض وفي مجرى صراعي.
لنعد الآن إلى فكرة المجلس العسكري في سورية، ولنتساءل: إذا كانت قوة الجيش قد أعطته، على الدوام، مدخلًا إلى الدور السياسي، فمن أين تأتي قوة هذا المجلس العسكري الذي لا جيش له؟ ولنفترض جدلًا أنه تم تشكيل جيش تحت أمرة المجلس المذكور، فوفق أي سياسة سيقود هذا المجلس الجيش المفترض؟ وإذا كان المجلس، كما يقال، تحت إمرة مدنية، فأين هي هذه الجهة المدنية؟ ولماذا الانشغال في فكرة مجلس عسكري في غياب “مجلس سياسي”؟ أليست الأولوية، منطقيًا، لبناء مجلس سياسي؟ تقودنا هذه الأسئلة إلى القول إن فكرة المجلس العسكري تنمّ، في أساسها، عن يأس مكين وأمل خجول؛ يأس من إمكانية تشكيل “مجلس سياسي”، أي من إمكانية إعطاء السياسة حقّها في السيادة الفعلية على العسكري؛ وأمل في استدراج دور خارجي (روسي غالبًا) مستقل أو بعيد نسبيًا عن نظام الأسد، يكون المجلس العسكري المقترح محلًا مناسبًا له.
ولكن يظلّ إبعاد الجيش عن السياسة لا يقلّ أهمية، لاستقرار سورية وبناء عافيتها، عن إبعاد الدين عن السياسة، هذه قاعدة ثابتة.
مركز حرمون