جذور الوجود الفردي وعطش الكتابة: المحتمل السيرذاتي في الشعر بوصفه مشروعا/ عبداللطيف الوراري
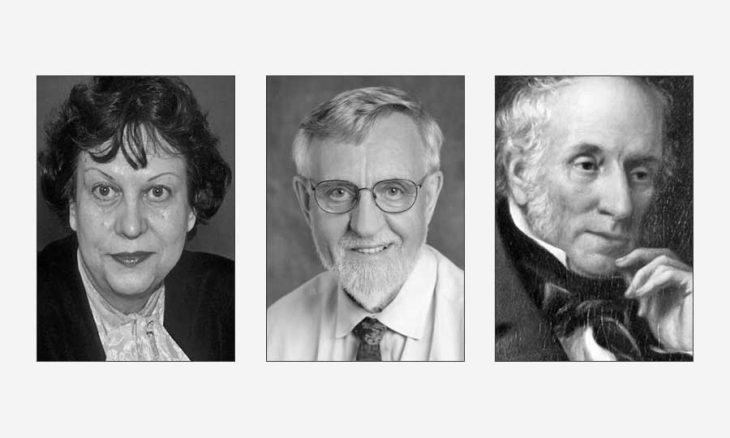
سبق أن أوضحنا في مقالات سابقة، أن السيرة الذاتية تتموضع بين الحقيقة التاريخية والإبداع التخييلي، وعليه يستحيل وضع أي تعريفٍ وصفي لها، أو وضع أي قيود عامة عليها إطلاقا. وإذا كانت الحقيقة السيرذاتية تكشف عن كونها وَهْماـ ، فإن للذاكرة دوراـ مُهماـ في السيرة الذاتية، وفي الروابط الضيقة والمركبة والمتبدلة التي غالبا ما تنبني بين الذاكرة والحياة المستعادة أثناء الكتابة؛ أي لن تعود الذاكرة بمثابة حضن للذكريات، بل هي عنصر فعال في تقديمها. فالوهم المرجعي الذي تنتجه السيرة الذاتية يجب أن لا يُخفي عنا حمولة التخييل المتضمنة فيه، إذ لا يمكن للمؤلف أن يأخذ بالاعتبار حياته كما جرت. إنه يصنع منها حَكْيا، بمعنى أنه يُكيف هذه الحياة مع الإكراهات المرتبطة بالشكل السردي، ويعيد تشييد حياته أثناء الكتابة وتبعا لما تمليه قوانينها الخاصة.
تسريد الزمن الشعري
رغم الاقتران الذي يكاد يكون بديهيا بين نوع السيرة والشكل النثري الاسترجاعي، فإننا نجد نصوصا شعرية يستلهم فيها أصحابها سيرهم الذاتية بطريقة نوعية ومخصوصة، بل إن بعضها يعلن صراحة انتسابه إلى هذا النوع، حتى إن تضمنتْ مثل هذه النصوص علاماتٍ إحالية على مرجع ما، بيد أن الشعر يعمل على إدماجها في سياقه التلفظي. وكما لاحظ جورج ماي فإن تعريف لوجون «فيه شيء من التصلب المفرط والتجمد المفرط» بحيث يترتب على اشتراطه النزعة النثرية القوْلُ بـ«أن السير الذاتية الشعرية من قبيل التمهيد الشهير لوردسورث Wordsworth (وقد وسمه صاحبه بعنوان فرعي؛ هو قصيدة سيرذاتية) ليست سيرا ذاتية». ولئن كان قول جورج ماي ورد في هذا السياق عَرَضا، إلا أن فيليب لوجون قد عاد، بعد نحو عقدين، إلى مفهومه للميثاق السيرذاتي، وخفف من غلواء التعريف ووجهه الدوغمائي، ولو أنه ما زال يلح على مقولة التطابق. لكن ناقدا مثل جيمس أولني أعطى المشكلة ما تستحقه من اعتبار؛ فهو يشير في كتابه «استعارات الذات: معنى السيرة الذاتية» (1972) إلى أن السيرة الذاتية ليست نَثْرا بالقوة، فهناك قصائد يمكن أن تُقرأ باعتبارها سيرا ذاتية، مثل قصيدة بول فاليري المطولة «بارك الشابة» التي يقترح تحليلها. كما توجد – في نظره – أوجه تشابه بين السيرة الذاتية والشعر، وهو يقول: «يُمثل السيرة الذاتية والشعر، بالفعل، شكلين من أشكال الإبداع وإعادة الإبداع، بحيث يستحضران طبيعة وجود الذات في الوعي، ويُحولان مُجرد الوجود إلى قيمة مُتحققة ومعنى ممكن. وبمعنى آخر، فالسيرة الذاتية والشعر يمثلان معا تعريفا للذات في لحظة ومكان معينين: لا أعني بذلك أن السيرة الذاتية هي تعريف لذات الكاتب في الماضي زمن الحدث، وإنما في الحاضر زمن الكتابة» ثم يضيء بقوله: «إن الفن في شكليه السيرذاتي والشعري هو أداة وساطة بين العالم الحسي والشعوري الزائل للحدث والوجدان، والحيز الثابت للأسلوب والدلالة».
ويرفض جيمس أولني في دراسة أخرى الحدود التقليدية للنوع، وهو يتناول التداخل الأنواعي أو التهجين الحاصل بين السيرة الذاتية والشعر بشكل أعمق، عندما اقترح أربعة بدائل ممكنة عن المفهوم التقليدي للحياة (bios) أي تاريخ الحياة الفردية التي عيشت سلفا: «الدافع الحيوي- دافع الحياة» «وعي خالص وبسيط» «المشاركة في وجود مطلق» و«المغزى الأخلاقي لكينونة الفرد». ووفق هذا المقترح، يرى أولني أنه يمكن للمرء أن يفهم الحياة التي تتمحور حولها السيرة الذاتية، من خلال طرق أخرى عدا الطريقة المشروعة والمعروفة التي تتمثل في سرد التاريخ الفردي:
ـ يمكن أن نفهمها باعتبارها الدافع الحيوي – دافع الحياة – الذي يتغير عندما يُعاش بواسطة الفرد بخاصة، وتبعا للتكوين النفسي الخاص والمتميز للشخص المعني.
ـ ويمكن أن نفهمها على أنها وعي خالص وبسيط؛ وعي لا يشير إلى أي أشياء خارج نفسه، ولا إلى أي أحداث وحيوات أخرى.
ـ ويمكن أن نفهمها على أنها مشاركة في وجود مطلق يتجاوز الواقع المتحول والمتغير للحياة الدنيوية إلى حد بعيد.
ـ ثُم يمكن أن نفهمها على أنها المغزى الأخلاقي للكائن الفرد.
وفي جميع هذه المعاني الأخيرة، لا تمتد الحياة إلى الوراء عبر الزمن، لكنها تمتد إلى جذور الوجود الفردي؛ إنها حياة لازمنية (خارج الزمن) حياة تحافظ على اندفاع عمودي من الوعي إلى اللاوعي، بدلا من أن تكون اندفاعا أو توجها أفقيا من الحاضر إلى الماضي. فالحياة هي سيرورة أكثر من أن يعتبرها ترتيبا زمنيا خطيا وجامدا لأحداث الماضي، فأي تعريف للحياة لا يمكن أن يكون إلا في حدود الوعي أو الحدس بآنيته، وهو ما يسمح بتسمية «شعر غنائي» ضمن نوع السيرة الذاتية، مثلما صنع أولني نفسه مع رباعيات ت. س. إليوت الأربع عندما عدها سيرة ذاتية.
المحتمل السيرذاتي
أعتقد أن مقترح جيمس أولني، مدعوما بآراء فلاسفة معاصرين وكتاب التخييل الذاتي؛ من أمثال جورج غوسدورف، وجون ستاروبنسكي، وبول ريكور، وسيرج دوبروفسكي مِمنْ شككوا في فرضية الصدق التي طرحها فيليب لوجون، يُفيدنا في إعادة النظر في الزمن السيرذاتي، وفي طبيعة كتابة الذات لحياتها الفردية وسرد تاريخها الشخصي/ اللاشخصي عندما يتعلق الأمر بالشعر بوجهٍ خاص؛ لأنه بدل الحديث عن ميثاق سيرذاتي متصلب، يمكن أن يتشكل بالأحرى ميثاقٌ تخييلي يُرجح فرضية (إعادة) بناء الذات، انطلاقا من صراع الذاكرة والنسيان أثناء الكتابة، وبالتالي فإن القول إن السيرة الذاتية تُشكل تمثيلا دقيقا وأصيلا لحياة المؤلف لن يكشف عن كونه إلا وَهْما.
وقد سبق أن ألمعت سوزان برنار، في مكانٍ آخر، إلى أننا لا نعثر داخل القصيدة على زمن استطرادي أفقي، تتخلله التفصيلات التفسيرية التي قد تضر بوحدتها وكثافتها و«لازمنيتها»؛ لأن زمن القصيدة ـ في نظرها – أقصر من زمن الرواية، عدا عن أن القصيدة «لا يمكن أن توجد كقصيدة إلا بشرط أن تقود إلى «الحاضر الأزلي» للفن فيصبح أكثر المدد الزمنية طولا، وأن تجمّد صيرورة متحركة في أشكال لازمنية – أشبه في ذلك بمتطلبات الشكل الموسيقي».
إن زمن القصيدة يتساند مع الميل إلى الإيجاز الذي يجعل من الحدث داخلها «بريقا آنيا ذا أثر آني في القارئ وليس أثرا متطورا». لا هو زمن أفقي، ولا دائري، بل هو عمودي يحاول عبر «الوثبة الإيكاروسية» التغلب على وطء الزمن نفسه واحتوائه من جديد بطريق من طرق الإيقاع الممكنة، وقياسا إلى بناء القصيدة: «الشكلية» أو «الدورية» المبنية على التقسيم إلى مقاطع شعرية، وعلى التكرير والتنظيم الإيقاعي، أو «القصيدة – الإشراق» التي تقطع مع كل أشكال المدة الزمنية (الزمان، المكان والاستنتاج المنطقي).
وقد انكب بول ريكور، في بحثه العلاقةَ بين الزمن والسرد، على العمليات الوسيطة بين تجربة المعيش والخطاب، مستدلا بنموذجي القديس أوغسطين في (اعترافاته) وأرسطو في (فن الشعر) فوجد في «مفهومه عن الحبكة muthos الجواب النقيض لانتشار النفس distentio animi عند أوغسطين» أي التوافق في مقابل التنافر. فما ينبغي على الشاعر أن يُؤْثره دائما هو المحتمل الشعري المقترن بمبدأ الإدهاش الذي يحدثه لدى المتلقي، بدل الممكن غير القابل للتصديق داخل الواقعة التاريخية المتعينة. وقد يغدو حتى المستحيل المقنع، على مستوى المتطلبات الفنية للشعر، أفضل من الأمر الممكن غير المقنع، لكن مع ذلك «يجب عدم البحث عن الممكن والعام خارج تنظيم الأحداث، ما دام هذا الربط نفسه ضروريا أو مُحْتملا». فالقصيدة لا تخلق لدى القارئ توقعات وحسب، بل بالأحرى قد تضفي مفاجآتها غير المتوقعة شعورا بالاكتمال لا يستطيع تفسيره إلا على نحو غامض، وقد تكون حتى النهاية المخيبة للآمال مُلائمة لبنية العمل الشعري نفسه.
للقصيدة، إذن، حبكةٌ خاصة بها، لكنها أكثر تجريدا من الحبكة النثرية، بشكل يلائم بناءها الفني ويحول دون اضمحلاله داخل السرد، كما ينبهنا إليه يوري لوتمان. وترتيبا عليه، فإذا كانت كتابة السيرة الذاتية نثرا تتقيد، في المجمل، بالبناء الزمني الخطي الذي يجري على وتيرة التنامي والتسلسل والتطور الحدثي، ويسترجع الحياة الشخصية تبعا لمفهوم التطابق اللوجوني، إلا أن كتابتها شعرا تكون بمثابة سيرورة أكثر من أن نعتبرها ترتيبا زمنيا خطيا وجامدا لأحداث الماضي، أي كتابة عن حياة ليست معطاة ومتاحة، بل هي «تمتد إلى جذور الوجود الفردي» بتعبير جيمس أولني. وهذا ما يتوافق مع منطق الخطاب الشعري الذي يعيد بناء ما كان «معطى سلفا» ويترك لدواله العمل عليه وتخييله من جديد إلى حد يستحيل معه أن تكون الحياة الشخصية هي نفسها استرجاعا وتمثيلا، أو ما تدل عليه من امتلاء وطمأنينة، بقدر ما هي تكون بفعل التحوير والقلب، حياة أخرى غيرها، مع ما توحي به من جهل وشك وفراغٍ وموت. وفي هذا المعنى، يكتب جون – ميشيل مولبوا: «يسعى العمل السيرذاتي للقصيدة، في بحثه وعناده، إلى إعادة بناء تكوّن الفرد (انظروا كيف أصبح هذا الذي هو أنا) بأقل ما يسعى إلى إظهار كيف أنه مهزوم، منخور بسبب عطشه، ومجوف من الداخل: كيف يخطو إلى المجهول واللاشخصي، أو بمعنى آخر يدخل في بعد «البشر العاديين» حيث نشترك على وجه التحديد في الجهل الذي نحنُ عليه». فالوعي الشعري بالمبدأ الحواري – الأنواعي وكيفية إعماله، شرط رئيسي في بناء المحتمل السيرذاتي، الذي تسنده خلفية كتابية مفتوحة، تخترقها ممارسات وشقوق وتشذراتٍ نصية، في ما هو يظل مُتمفْصلا ـ بحدة – بين سيرة ذاتية لا تريد الإفصاح عن نفسها، وتخييل لا يريد الانفكاك من سيرة مؤلفها. وليس الذي يهمنا، والحالة هذه، هو حياة الفرد التي يشعر بها الآخرون كمتواليةٍ من الأحداث المرتبطة به، ولا أن تتخذ عبر اللغة شكْلَ حكيٍ استرجاعي لا يحترم بالضرورة النظام الكرونولوجي دائما، فهذا أمرٌ بديهي من وجهة نظر عملية؛ لكن أي الكيفيات البانية التي اتخذها لتمثيل تلك الحياة التي يزعم أنه يستعيدها في حاضر الكتابة ويرقش بها جسدها النصي؟ وهذا الأمر في حد ذاته يستتبع مشكلات أبستيمولوجية تُثار أثناء ممارسة الذات لفعل الكتابة.
إعادة بناء ذاتي
السيرة الذاتية، خارج التصور اللوجوني، هي تخييل وإعادة بناءٍ ذاتي، وعبر جماع ذلك، تحضر اللغة بوصفها طِرْسا للتعبير عن الذات، واكتشاف الذات. ليست ذات السيرة الذاتية هي الأنا، بل الكتابة ذاتها. وإذا كانت السيرة الذاتية سوى تَخْييلٍ للذات، فإن هذا التخييل هو مُهم للغاية؛ ليس بالقياس إلى صدق ما يكتبه الأنا السيرذاتي وحرصه على التمثيل الوقائعي الوفي للأحداث، وإنما إلى الكيفية التي يستطيع بها تمثيل الذات وإعادة بنائها، سواء في صراعها مع الحقيقة، أو في بحثها عن الهوية من خلال فعل الغيرية.
يقودنا هذا الكلام إلى استخلاص نتيجة أساسية؛ وهي أن الكتابة الشعرية عن طريق استثمارها للبعد السيرذاتي، إنما تبني محكي الحياة وتعيد بناءه وفق قوانينها الخاصة، بما هي ممارسة نوعية ومفتوحة تخترقها أشكال من الابتكار والتحول والتشطيب والمحو واللعب. فأنا الشاعر يبني سيرته ويضيف إليها، ويستثمرها باعتبارها مشروعا داخل خطابه الخاص، وعبر فعالية الـمُخيلة، بما تقود إليه من استعارة ولعب ومحو واختلاف، وهي على نحوٍ مُضاعَفٍ تنهض بشرائط وجوده في حاضر الكتابة. فالمرجعية الاستعارية – التحويلية في الشعر تنقض المرجعية الإحالية – الوثوقية وتلغي فاعليتها على قدر الإمكان، وتبدو اللغة مُـحْتفى بها لذاتها على حساب وظيفة الخطاب اليومي، الذي يتحول لصالح ما يمكن أن يسميه بول ريكور بالتغيرات الواسعة الخيال، التي يجريها الأدب على الواقع، حيث تنزاح الكتابة ـ هنا – من ملفوظات الواقعي بما ينطوي عليه من مؤشرات خارج النص، إلى ملفوظات التخييلي بما يترتبُ من إعادة بناء.
وإذن، فالكتابة السيرذاتية في سياق الشعر هي غيرها في سياق النثر؛ إذ تتطلب من الشاعر أن يقول أناه ويستعيده تخييليا من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن يستلهم ملامح سيرته عبر رؤية نوعية تتقيد بقوانين هذه الكتابة لبناء محتملها السيرذاتي.
كاتب مغربي
القدس العربي




