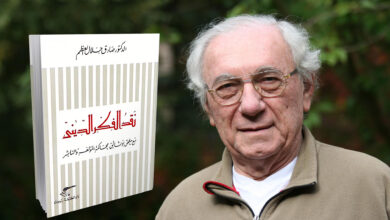مقطع من رواية شتيلر لـماكـس فـريـش

ترجمة: سمير جريس
الجزء الأول: مذكرات شتيلر في السجن
الكراسة الأولى
لستُ شتيلر!
يوما بعد يوم، ومنذ إيداعي هذا السجن الذي سأصفه لاحقا، أردد ذلك، وأقسم على ذلك، وأطلب الويسكي وإلا رفضت الإدلاء بأي أقوال أخرى. فبدون ويسكي، هذه هي خبرتي، لا أكون أنا ذاتي، بل أميل إلى الوقوع صريع كافة التأثيرات الجيدة الممكنة، أميل إلى تأدية دور مناسب لكم تماما، لكن هذا الدور ليس له أدنى علاقة بي؛ ولأن كل ما يهمني في وضعي العبثي الآن (إنهم يعتبرونني مواطنا مفقودا من مواطني مدينتهم الصغيرة!) هو ألا أسمح لهم بإقناعي بثرثرتهم، وأن أقابل باحتراس كل محاولاتهم اللطيفة الرامية إلى إدخالي في جلد إنسان غريب، وأن أظل ثابتا على موقفي إلى درجة الفظاظة؛ أقول: لأن كل ما يهمني هو ألا أكون أحدا آخر غير الإنسان الذي هو في الحقيقة – وللأسف الشديد – أنا، فلن أتوقف عن الصراخ طالبا الويسكي كلما اقترب أحد من زنزانتي. بالمناسبة، لقد توجب عليّ قبل أيام أن أبلغهم بأنه ليس من اللازم أن يكون الويسكي من أجود الأنواع، يكفي أن يكون نوعا معقولا، وإلا ظللت واعيا منتبها، وليحققوا معي عندئذ كما يريدون، ولن يخرجوا مني بشيء، على الأقل لن يخرجوا بشيء حقيقي.
لكن دون جدوى! يحضرون لي اليوم هذه الكراسة المكدسة بالأوراق البيضاء: عليّ أن أدوّن حياتي! بالتأكيد للبرهنة على أن لي حياة، حياة أخرى غير حياة السيد المفقود شتيلر الذي يدعونه.
قال لي المحامي الذي كلفه القضاء بالدفاع عني:
اكتب الحقيقة، لا شيء إلا الحقيقة الخالصة والبسيطة. يمكنك في كل وقت الحصول على الحبر لإعادة ملء قلمك!
مرّ اليوم أسبوع على الصفعة التي أدت إلى اعتقالي. كنتُ (حسب المحضر) ثملاً إلى حد كبير، ولذلك أجد صعوبة في وصف السير الظاهري للأحداث.
قال شرطي الحدود:
تعال معي!
من فضلك، لا تعقد الأمور، قطاري سيواصل السير في أي لحظة.
رد شرطي الحدود:
ولكن مِن دونك.
الطريقة التي انتزعني بها من فوق درجة سلم القطار، قضت على أي رغبة داخلي في الإجابة عن أسئلته. كان يمسك بجواز السفر في يده، وكان الموظف الآخر الذي يختم جوازات سفر الركاب لا يزال في القطار. سألتُ:
ما المشكلة في جواز السفر؟
لا رد. ثم كرر عدة مرات:
لا أقوم إلا بواجبي، أنت تعلم ذلك تماما.
دون أن يعير بالا إلى سؤالي عن سبب المشكلة في جواز سفري – مع أنه جواز سفر أمريكي سافرت به حول نصف الكرة الأرضية! – كرر أمره بلكنته السويسرية:
تعال معي!
من فضلك، إذا لم ترد أن تنال صفعة يا سيدي، فلا تمسك بكُمي؛ أنا لا أطيق هذا.
إلى الأمام!
رغم تحذيري المهذب والواضح قال شرطي الحدود الشاب، بسحنة شخص متعجرف عجرفة يحميها القانون، إنهم سوف يخبرونني مَن أنا في الحقيقة، فصفعته. في حركة لولبية تدحرج على رصيف المحطة “الكاب” الأزرق الغامق الذي يضعه فوق رأسه، وابتعد أكثر من المتوقع. لوهلة استولى الاندهاش التام على شرطي الحدود الذي بدا الآن بدون “كاب” أكثر إنسانية عما قبل. تملكه الذهول. لم يكن غاضبا، حتى أنه كان بإمكاني أن أصعد إلى القطار بسهولة. في تلك اللحظة دارت عجلات القطار، ومن النوافذ تدلى الملوّحون. باب إحدى العربات ما زال مفتوحا. لا أعلم لماذا لم أقفز لأركب. كان بإمكاني، حسب ما أظن، نزع جواز السفر من يده، إذ إن الذهول كان قد استولى على الشاب تماما كما قلت، وكأن روحه تسكن وتستقر في ذلك “الكاب” المتدحرج، ولهذا لم يتملكه الغضب المفهوم إلا عندما توقف – ذلك “الكاب” المقوى – عن الدحرجة. انحنيت وسط الناس، وبكل جهدي رحت أنفض الغبار، بعض الشيء على الأقل، عن “الكاب” الأزرق الداكن ذي الصليب السويسري المثبت عليه كشعار قبل أن أسلمه إليه. احمّرت أذناه بشدة. كان الأمر غريبا، لقد سرت خلفه وكأنني مجبر على ذلك بدافع من استقامتي. دون أن ينطق بكلمة، ودون أن يلمسني، وهو ما لم يكن ضروريا، قادني إلى قسم الشرطة حيث تركوني خمسين دقيقة كاملة أنتظر. قال المفتش:
– تفضل بالجلوس!
كان جواز السفر على المكتب. تعجبت على الفور من اللهجة المختلفة التي تكلم بها، كان يجتهد في أن يكون مهذبا، لكنه لم يكن مقنعا جدا، وهو ما حملني على الاستنتاج بأن جنسيتي الأمريكية – بعد نحو ساعة من فحص جواز سفري – كانت فوق كل الشبهات. ليس هذا فحسب، لقد سعى المفتش – وكأنه يريد تعويضي عن فظاظة الشرطي الشاب – إلى إيجاد “فوتيه” من أجلي. قال:
كما أسمع فإنك تتحدث الألمانية.
ولم لا؟
ابتسم وقال لي:
تفضل بالجلوس.
ظللت واقفا، ثم قلت مفسرا:
أنا من أصل ألماني، أمريكي من أصل ألماني.
أشار إلى “الفوتيه” الشاغر:
تفضل!
تردد لوهلة قبل أن يجلس هو … لو لم أكن لطيفا وتحدثت بالألمانية في القطار، لربما كنتُ وفرتُ على نفسي كل هذا! كان راكب آخر، سويسري، قد بادرني بالحديث. لقد كان حاضرا أيضا كشاهد على صفعتي، هذا المسافر الذي أثار أعصابي منذ باريس. لا أعرف من هو هذا السيد الذي لم أره من قبل قط. في باريس دخل إلى المقصورة، وأيقظني بتعثره في قدمي، ثم وضع حقائبه، واندفع معتذرا بالفرنسية ناحية النافذة المفتوحة لكي يودع بلهجته السويسرية سيدة ما؛ وما كاد القطار ينطلق حتى استولى عليّ شعور مزعج بأنه يتفحصني. تحصنت خلف مجلتي، “النيويوركر”، التي كان واضحا عليها أنها قُرئت من قبل، والتي كنت أعرف كل رسومها الكاريكاتورية، وذلك على أمل أن يفقد جاري في السفر فضوله. كان هو أيضا يقرأ جريدة، جريدة سويسرية. بعد أن اتفقنا بالفرنسية على إغلاق النافذة، كنت أتجنب إرسال نظرة كسولة عبر النافذة إلى الطبيعة بالخارج؛ فقد كان من الواضح أن هذا السيد – الذي قد يكون، بالمناسبة، إنسانا جذابا – يتحيّن الفرصة لتبادل الحديث، حديث مرتبك من ناحيته إلى درجة أنه لم يكن أمامي في النهاية سوى الذهاب إلى عربة البوفيه في القطار، حيث جلست خمس ساعات كاملة، احتسيت فيها عددا من الكؤوس. غير أن اقتراب المعبر الحدودي أجبرني بين ميلوز وبازل على العودة إلى المقصورة. تطلع السويسري إليّ مرة أخرى، وكأنه يعرفني. لا أدري ما شجعه فجأة على بدء الحديث معي؛ ربما لأننا الآن في بلاده. سألني مرتبكا بعض الارتباك:
معذرة! ألستَ السيد شتيلر؟
كما قلت، كنت قد احتسيت بعض الويسكي، ولم أفهم سؤاله، فأمسكت بجواز سفري الأمريكي في يدي، بينما راح السويسري، بعد أن رجع إلى الحديث بلهجته، يقلب أوراق مجلة. وقف خلفنا موظفان، أحدهما من شرطة الحدود، والآخر يمسك بختم في يده. سلّمت جواز السفر. شعرت الآن بأنني شربتُ كثيرا. نظرا إليّ نظرات ريبة. لم يكن في متاعي القليل أي مشكلة. سألني الآخر:
هل هذا هو جواز سفرك؟
ضحكت في البداية بالطبع. سألته:
ولم لا؟
ثم أضفت بنبرة كادت تكون ساخطة:
ما المشكلة في هذا الجواز؟
كانت تلك هي المرة الأولى التي يشك فيها أحد في جواز سفري، لا لشيء إلا لأن هذا السيد قد خلط بيني وبين صورة في مجلته …
قال المفتش مخاطبا هذا السيد:
– السيد الدكتور، لا أريد أن أؤخرك أكثر من هذا، إنني أشكرك على كل حال على المعلومات التي قدمتها.
واقفا في إطار الباب، بينما كان المفتش المُمتن يمسك بالمقبض، أومأ إلي هذا السيد، وكأن كلا منا يعرف الآخر. السيد الدكتور، هناك الآلاف مثله. لم تكن لدي أدنى رغبة في أن أومئ إليه. عندئذ عاد المفتش، وأشار مرة أخرى إلى الفوتيه، ثم قال:
تفضل! كما أرى، يا سيد شتيلر، فإنك في حالة سُكر بيّن …
شتيلر؟ اسمي ليس شتيلر!
واصل حديثه دون أن يلتفت إليّ:
آمل أن تفهم، رغم ذلك، ما أريد أن أقوله لك، يا سيد شتيلر.
هززت رأسي نافيا، وخلال ذلك قدم لي تبغا، ما يطلقون عليه سيجاريلو. بالطبع رفضت، لأنه كان من الواضح أنه لا يعرضه عليّ أنا، بل على السيد المدعو شتيلر. كما أنني ظللت واقفا، في حين أن المفتش كان قد جلس وكأنه سيبدأ حديثا مسهبا. سألني:
لماذا انفعلت عندما سئُلت عما إذا كان هذا هو جواز سفرك؟
وراح يقلّب في جوازي الأمريكي. قلتُ له:
السيد المفتش، أنا لا أطيق أن يمسك أحد بكمي. لقد حذرت مرؤوسك، شرطي الحدود الشاب، عدة مرات. أشعر بالأسف، سيادة المفتش، لأني اندفعت وصفعته، وبالطبع أنا مستعد لأن أدفع الغرامة المألوفة هنا. هذا أمر بديهي. كم تبلغ قيمتها؟
ابتسم ابتسامة لا تخلو من لطف. “الأمر ليس بهذه البساطة”، هكذا قال مشعلاً لنفسه بعناية “سيجاريلو”، وذلك بأن دحرج السيجاريلو البُني بين شفتيه قليلا، بكل استرخاء ودقة، وكأن الوقت لا يلعب أي دور.
يبدو أنك رجل معروف جدا …
أنا؟ لماذا؟
أنا لا أفهم شيئا في مثل هذه الأشياء، لكن يبدو أن السيد الدكتور، الذي تعرف عليك، يحمل لك تقديرا كبيرا جدا.
لا جدوى: الخلط قد حدث، وكل ما سأقوله الآن، لن يبدو إلا نوعا من التدلل، أو التواضع الحقيقي. سألني:
لماذا تسمي نفسك “وايت”؟
تحدثتُ، وتحدثتُ. فسألني:
من أين حصلت على جواز السفر هذا؟
راح يتصرف كأنه في بيته، فأخذ يدخن “السيجاريلو” ذا الرائحة البغيضة بعض الشيء، شابكا إبهاميه في حمالتي سرواله، فالعصر كان حارا رطبا، ثم فتح المفتش – لا سيما أنه لم يعد يعتبرني أجنبيا – بعض أزرار سترته التي لم تكن مناسبة للطقس، في حين راح يتفحصني دون أن يسمع كلمة واحدة مما أقول.
قلتُ له:
سيادة المفتش، أنت محق، محق تماما، أنا سكران، ولكني أعترض على أن يقوم سيد ما، دكتور ما، لا أعلم من أين أتى …
يقول إنه يعرفك.
من أين؟
رد قائلا:
من المجلات.
ثم استغل فترة صمتي الطافح بالاحتقار لكي يضيف:
لديك زوجة تعيش في باريس. هل هذا صحيح؟
أنا؟ زوجة؟
اسمها يوليكا.
قلت له موضحا:
لم آتِ من باريس، سيادة المفتش، بل من المكسيك.
أعطيه البيانات التالية: اسم الباخرة، مدة الرحلة البحرية، ساعة وصولي إلى “لو هافر”، ساعة سفري من “فيرا كروز”.
هذا ممكن، لكن زوجتك تعيش في باريس. وهي راقصة، إذا كنت فهمت الأمر على نحو صحيح. ويُقال إنها امرأة رائعة الجمال.
التزمت الصمت. أضاف المفتش شارحا:
يوليكا هو اسمها الفني. يقولون إنها كانت مصابة بداء في الرئة، وكانت تعيش في دافوس. ولكنها الآن تدير مدرسة باليه، أو شيئا كهذا، في باريس. هل هذا صحيح؟ منذ ست سنوات.
تطلعتُ إليه دون تعليق.
منذ أن أصبحت مفقودا.
كنت قد جلست لا إراديا، حتى أسمع كل ما يعرفه قراء إحدى المجلات المصورة عن إنسان يبدو – على الأقل في عيني دكتور ما – أنه يشبهني، ثم سحبت سيجارة، فأشعلها لي المفتش بعد أن انتقلت إليه عدوى الاحترام والتبجيل اللذين نشرهما ذلك الدكتور في الأجواء.
أنت إذاً نحّات.
ضحكت.
سألني دون أن ينتظر إجابة:
صحيح؟
ثم واصل أسئلته على الفور:
لماذا تسافر باسم مستعار؟
لم يصدقني حتى عندما أقسمت.
قال لي وهو يُخرج استمارة زرقاء من أحد الأدراج:
أنا آسف يا سيد شتيلر، ولكن إذا ظللت تمانع في إظهار جواز سفرك الحقيقي، فأنا مضطر إلى تسليمك إلى الشرطة الجنائية. يجب أن يكون هذا واضحا لك.
قال ذلك وهو ينفض رماد “السيجاريلو”.
لستُ شتيلر!
كررت هذه الجملة عندما بدأ يملأ الاستمارة الطويلة بكل دقة، لكنه على ما يبدو لم يكن يسمعني مطلقا؛ حاولت أن أقول الجملة بكافة طبقات الصوت؛ قلتها على نحو احتفالي، وعلى نحو موضوعي. أقول:
سيادة المفتش، ليس لدي جواز سفر آخر!
أو أضيفُ ضاحكا:
هذا هراء!
رغم سُكري كنت أشعر بدقة تامة أن تجاهله لي يزداد، كلما كررت الجملة؛ وفي النهاية صرخت:
اسمي ليس شتيلر، اللعنة!
صرخت وخبطتُ بقبضتي على المكتب.
ولماذا تنفعل هكذا؟
نهضتُ، وقلت له:
سيادة المفتش، أعطني جواز سفري حالا!
لم يتطلع حتى إليّ.
أنت مقبوض عليك.
وراح يقلب بيسراه في جواز سفري حتى ينقل رقم الجواز، وتاريخ الإصدار، واسم القنصل الأمريكي في المكسيك، أي كل ما تريد الاستمارة الزرقاء معرفته في حالة كهذه، ثم قال بنبرة لا تخلو من الود:
تفضل بالجلوس!
زنزانتي – لقد قستها بحذائي الذي يبلغ بالكاد ثلاثين سنتيمترا – صغيرة مثل كل شيء في هذا البلد، نظيفة حتى إن المرء لا يستطيع أن يتنفس من النظافة، وتثير شعورا بالضيق، تحديدا لأن كل شيء مضبوط، ومُلائم، وكاف. لا أكثر ولا أقل! كل شيء في هذا البلد متوفر على نحو يثير الضيق. لقد قستها: الطول 3,10 م، العرض 2,40 م، الارتفاع 2,50 م. سجن إنساني، لا يستطيع أحد انتقاد شيء فيه، وهنا تحديدا تكمن الدناءة. لا خيوط عنكبوت، لا آثار للمياه على الجدران، لا شيء يبرر سخط المرء! هناك زنازين يقتحمها الشعب عندما يسمع عن وجودها، أما هنا فلا يوجد ما يُقتَحم. ملايين من البشر، أعرف ذلك، يسكنون في ظروف أسوأ مني. السرير مزود بالنوابض، شمس الصباح تدخل من الشباك ذي القضبان، وتظل في هذا الوقت من العام حتى الحادية عشرة. للمائدة دُرجان؛ وهناك أيضا كتاب مقدس، وأباجورة كبيرة. وإذا أردت قضاء حاجة، فليس عليّ إلا أن أضغط على زر أبيض، فيأخذوني إلى المكان المقصود، وهناك لا يستخدم المرء صحفا قديمة، يمكنه قراءتها قبل ذلك، بل يجد ورقا طريا ناعما. ورغم ذلك فهي زنزانة، وهناك لحظات يشعر فيها المرء برغبته في الصراخ. لكنه لا يفعل، مثلما لا يفعل ذلك في متجر من المتاجر، بل يجفف يديه في منشفة، ويسير على الأرضية المغطاة بالمشمع، ويقول شكرا عندما يغلقون الباب خلفه بعد أن يدخل زنزانته. لا أرى شيئا غير الأوراق الخريفية على شجرة كستناء، ولا أرى شيئا حتى عندما أصعد السرير ذي النوابض، وهو بالمناسبة (أعني الصعود بالحذاء) من الممنوعات. أكثر ما يعذبني هو بالطبع الأصوات مجهولة المصدر؛ منذ أن عرفت أن هذه المدينة الصغيرة يسير بها ترام، استطعت أن أتجاهل ضوضاءه تقريبا. أما الأمر السيء فهو كلام المذيع غير المفهوم من راديو الجار، والضجيج الصادر عن عربات جمع القمامة، والدق الجنوني على الأبسطة المتصاعد من الأفنية. يبدو أن لدى الناس في هذه البلاد خوفا مَرَضيا تقريبا من القذارة. بالأمس بدأوا يتحدثون معي عبر التهتهة الصادرة عن المطرقة الثاقبة، فهم يشقون بطن أحد الشوارع في مكان ما لكي يعيدوا تبليطه بالأحجار الصغيرة فيما بعد. أشعرُ في كثير من الأحيان بأنني الإنسان الوحيد المعتدل في هذه المدينة الصغيرة. حسب الأصوات القادمة من الشارع – عندما تتوقف المطرقة عن الحفر – فإنهم هنا كثيرا ما يسبّون، ونادرا ما يضحكون. وفي منتصف الليل تقريبا يعلو زعيق السكارى غير المفهوم، فعندئذ تُغلق كافة الحانات. ذات مرة راح طلبة يغنون، وكأننا في أعماق الريف الألماني. نحو الواحدة صباحا يسود السكون. إطفاء الضوء لا يفيد كثيرا؛ فضوء المصباح البعيد في الشارع يدخل زنزانتي، فتتمدد ظلال القضبان على طول الحائط، ثم تنكسر في السقف، وعندما تهب رياح شديدة بالخارج وتؤرجح مصباح الشارع، يكاد المرء يُجن من ظلال القضبان المتأرجحة. على الأقل ترقد تلك الظلال على الأرضية في الصباح، عندما تشرق الشمس.
بدون حارسي الذي يأتي بالطعام، لن أعرف ما يحدث هنا على الإطلاق. يبدو أن كل قارئ من قراء الصحف هنا يعلم مَن هو شتيلر. وهذا ما يجعل معرفة التفاصيل الدقيقة مستحيلة تقريبا؛ فكل شخص يتصرف وكأن الجميع يعرفون كل شيء، في حين أنه هو نفسه لا يعرف إلا معلومات تقريبية.
قال لي الحارس وهو يملأ المغرفة بالحساء:
لفترة ما، على ما أعتقد، بحثوا عنه في البحيرة، ولكن دون جدوى، وفجأة قالوا إنه في الفيلق الأجنبي.
ثم شرح لي:
هذا ما يفعله سويسريون كثيرون، عندما يشعرون بالضيق من كل شيء هنا.
فيتقدمون إلى الفيلق الأجنبي؟
ثلاثمئة في العام الواحد!
ولماذا الفيلق الأجنبي؟
لأنهم يضيقون بكل شيء هنا.
واضح، ولكن لماذا الفيلق الأجنبي؟ إنه أسوأ بكثير.
الأمر بالنسبة لي سيان.
وزوجته تركها ببساطة، وهي المريضة، راقدة في دافوس؟
ربما كان الأمر نعمة بالنسبة إليها!
أهذا رأيك؟
الأمر بالنسبة لي سيان، منذ ذلك الوقت وهي تعيش في باريس.
أعرف!
راقصة.
أعرف!
امرأة رائعة الجمال.
سألته وكلي مشاركة وجدانية:
وماذا عن مرض رئتها؟
شُفيت.
من يقول ذلك؟
هي نفسها.
ومن أين تعرف كل هذه المعلومات؟
– مِن أين!
كررها حارسي، ثم أضاف:
– من المجلات المصورة.
لم يكن يعرف المزيد.
قال لي الحارس:
– تناول طعامك! اشرب الشوربة وهي ساخنة، ولا تفقد أعصابك يا مستر وايت. لا ينتظرون إلا ذلك، هؤلاء السادة الدكاترة، إنني أعرفهم!
كانت الشوربة – شوربة خضار – جيدة، وعموما لم يكن الطعام يثير شكواي. أعتقد أن حارسي كان طيبا معي، على كل حال لم يخاطبني قط (وهو ما يفعله الآخرون كلهم!) بـ “هِر شتيلر”، بل بـ”مستر وايت”.
يجب عليّ أن أحكي! أحكي حقيقة حياتي، الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة العارية، الخالصة! رزمة من الورق الأبيض، قلم ممتلئ بالحبر أستطيع في كل وقت إعادة ملئه على حساب الدولة، إضافة إلى بعض من النية الطيبة: ماذا يتبقى أمام الحقيقة غير الرضوخ لي عندما آتي إليها بقلمي! إذا التزمت بالوقائع على طول الخط، هكذا يقول محاميّ، فستكون الحقيقة مبذولة أمامنا، وتقريبا دانية القطاف. وإلى أين ينبغي أن تذهب الحقيقة إذاً، عندما أدونها؟ أما ما يقصده محاميّ بكلمة وقائع فهو بالأخص، وعلى ما أعتقد، أسماء الأماكن والتواريخ التي يمكن التأكد من صحتها، بيانات عن المهنة مثلا، أو دخلي من أشياء أخرى، ومدة الإقامة، وعدد الأطفال، ومرات الطلاق، والمذهب الديني، إلخ.
ملحوظة
أين كنتُ في الثامن عشر من يناير 1946؟
المشي في ساحة السجن:
منذ فترة طويلة لم يعد الأمر سيئا، أو مهينا، مثلما كان المرء يتوقع، وأنا سعيد حقا بأنني أستطيع أن أتمشى مرة أخرى، حتى وإن كان ذلك يقتصر على المشي في دوائر فحسب. الساحة واسعة إلى حد كبير؛ مبلطة، وبين البلاطات نمت طحالب، وفي المنتصف شجرة قيقب جميلة، وعلى أحد الجدران نما لبلاب؛ وبالطبع كان من الأشياء الفارقة أننا لم نكن نرتدي ملابس المعتقلين بعد، بل كنا بثيابنا المدنية التي ألقوا القبض علينا بها. إذا وسع المرء قليلا الدائرة التي نتمشى فيها، فإنه يرى شرفة على سقف أحد المنازل وبها غسيل يرفرف؛ عدا ذلك لا يرى المرء فوق الأسقف المحيطة بنا إلا السماء التي تزدحم بالحمام الهادل. علينا للأسف أن نبقى في طابور واحد، ولهذا يستحيل إجراء حديث حقيقي. يسير أمامي شخص بدين بصلعة لامعة (مثلي) وبثنيات من الشحم على قفاه، وهو يجذف بذراعيه كلما توجب عليه السير، على الأرجح سجين جديد؛ شبه متخشب، وشبه شارد الذهن، إذا طالبه حارس لطيف بمواصلة المشي، فإنه يستدير، وهو ما يسبب له مجهودا بدنيا، باحثا بنظراته الصامتة عن أحد يسانده. يسانده على أي شيء؟ يسير خلفي رجل إيطالي يحب الغناء تحت الدش، فلا يتمالك الحراس أنفسهم من الضحك؛ ثم يلفت الانتباه عندما يأخذ في تقليدي. ذات مرة ألقيت نظرة إلى الوراء حتى أتعرف على صورتي؛ الأمر مثير للضحك فعلا: اليدان خلف الظهر، وضع المفكر، وكنتيجة لشرود الذهن أخرج دائما من الطابور، ملامح الحنين إلى الوطن على وجه يرسل نظرات تفيض وحدة تتجاوز السور التالي المبني بالطوب الأحمر، شخص يتخيل بخجل أنه لا ينتمي إلى هذا المكان، بالإضافة إلى ذلك ثمة لطف مرتبك يميز المثقفين. لا بد أنها صحيحة، هذه الصورة، على كل حال فحتى اليهودي وجد نفسه يضحك، وهو المثقف الوحيد بين المساجين الذي يسير للأسف في النصف الآخر من الدائرة، ولهذا لا نستطيع أن نتبادل شيئا من الحديث إلا عبر الإيماءات والإشارات. يبدو عليه اليأس فيما يتعلق بالعدالة السويسرية …
وفجأة، بدأ أحدهم في لعب كرة القدم بحبة بطاطس نيئة. يتبادلون الكرة بمهارة عدة مرات إلى أن استطاع رئيس الحرس – وهو رجل منضبط بشدة ويشعر بالإهانة الشخصية إذا حدث شيء يخالف السلوك المنضبط – الإمساك بحبة البطاطس أخيرا. انتباه! سؤال جاد: من أين أتت حبة البطاطس؟ نصمت في الدائرة، ونضحك بشماتة. يمر بنا رئيس الحرس، وفي يده حبة البطاطس التي أصيبت بعاهات مستديمة، يمر بكل رجل، وينظر في عينيه، فيهز كلٌ منا كتفيه. فلتت من رئيس الحرس اللحظة المناسبة لإلقاء حبة البطاطس بعيدا؛ رغما عنه اكتسب الموضوع أهمية، أهمية مبدئية. أشعر أن الأمر كله ساخر، وأن رئيس الحرس يحاول جاهدا ألا يضحك، وأنه سيخلي سراحنا؛ وفي الوقت نفسه ينتابني شعور: ربما يكونون قد جهزوا لنا وسيلة تعذيب، وتكفي حبة البطاطس المسروقة لكي يدخلوا علينا بالحديد المتوهج. وفجأة يطلب اليهودي الكلام. تعلو الضحكات من كل جانب! حتى رئيس الحرس لاحظ أن هذا الاعتراف (إنه لم ير في حياته قط يهوديا يلعب كرة قدم) ليس سوى تهكم منه، وهو أمر أسوأ من سرقة حبة بطاطس غير مطبوخة. على اليهودي أن يخرج من الطابور. كان شاحبا من الانفعال. تحتم على الآخرين الركض خمس دقائق. راح البدين المسكين أمامي يهتز مثل قربة من المطاط، فتخلف عنا بالطبع منذ الدورة الأولى. سار في خط لولبي حتى يختصر الطريق، إلى أن قال له أحد الحراس إن عليه أن يتوقف. لم تنتزع الرحمة بعد من قلوب الناس. لكن، بالطبع، لا بد من النظام، وبعض الجدية أيضا. فنحن في خاتمة المطاف سجناء على ذمة التحقيق … أحيانا، وأنا وحدي في زنزانتي، يتولد لدي شعور بأنني أحلم بكل هذا فحسب؛ شعور بأنني قد أنهض في أي وقت، وأبعد يدي عن وجهي، ثم أتلفت حولي في حرية، فالسجن ليس إلا داخلي فحسب.
قال لي محاميّ الذي كلفه القضاء بالدفاع عني:
لقد بذلت جهدي، حتى تكون إقامتك في الحبس الاحتياطي، القصيرة على ما نأمل، مريحة بقدر الإمكان. الويسكي ممنوع! لديك أفضل زنزانة في السجن كله، صدقني، ليست الأكبر، لكنها الوحيدة التي تدخلها شمس الصباح؛ أمامك منظر شجر الكستناء العتيق. أما فيما يخص قرع أجراس الكاتدرائية، وهو عال جدا، أعترف بذلك؛ ولكن ماذا تنتظر مني! لا أستطيع أن أنقل الكاتدرائية إلى مكان آخر!
هذا صحيح، تماما مثل أن كل شيء يقوله محاميّ يكون صحيحا على نحو لا يقنعني قط، بل يجعلني دائما مخطئا. إن قرع أجراس الكاتدرائية، هذا الدوي المعدني الذي ينطلق مرتين في اليوم، على الأقل مرتين، إذا لم يكن ثمة عقد قران أو جنازات، إنه ضجيج يحول دون أن يسمع المرء صوت أفكاره، الهواء يرتعش عندئذ، زلزال لا يصدر صوتا، صوت يشبه قفزة الإنسان في الماء من منصة وثب عالية، صوت يجعلني أصم، دائخا، معتوها؛ لكن محاميّ محق: لا يستطيع نقل الكاتدرائية إلى مكان آخر! ولأنني أصمت عندئذ، أصمت يأسا، فإنه يمسك بملفه ويقول:
طيب … فلندخل في الموضوع!
محاميّ إنسان طيب القلب، على الأقل سليم النية، من عائلة محترمة، مستقيم حتى في ملابسه، ليس على سجيته تماما، ولكن حتى ذلك يتحول إلى أسلوب مميز؛ وهو في المقام الأول عادل، لا شك في ذلك، عادل حتى في الأمور التافهة، عادل إلى حد يدفع إلى اليأس، عدله يكاد يكون نابعا من اقتناع ولد به بأن العدالة لا بد أن تسود، على الأقل في دولة القانون، وعلى الأقل في سويسرا. كما أنه ليس غبيا. إنه غزير المعلومات، وموثوق به كدائرة معارف، لا سيما فيما يتعلق بسويسرا، ولهذا لا جدوى من الحديث مع محاميّ عن سويسرا؛ كل فكرة تضع سويسرا موضع مساءلة، سيخنقها تحت ركام من الحقائق التاريخية التي لا يمكن إنكارها، وفي النهاية، إذا لم يمتدح المرء سويسرا كما يراها، فإنه يصبح دائما مخطئا، فعلا وحقا، مثلما يتضح من قرع أجراس الكاتدرائية. ربما برودة مشاعره هي التي تثير أعصابي إلى أبعد الحدود، سلوكه الصائب، اعتداله. يفوقني ذكاء، لكنه لا يستخدم ذكاءه كله إلا لكي يتجنب الوقوع في أخطاء. إنني أشعر بالتقزز تجاه أولئك الناس! لا أستطيع أن أجد فيه عيبا واحدا، وهو يعتبرني إنسانا طيب القلب، أو على الأقل سليم النية، إنسانا في جوهره عاقلا تماما، ذا نية طيبة، إنسانا سويسريا. من هذا المنطلق يدافع عني، ويجعلني في كل مرة أنفجر غيظا. عندئذ أستدير على كعبي، وأسمح له بالجلوس على سريري، معطيا له ظهري، وصامتا إلى حد الفظاظة، مطلقا بصري إلى شجر الكستناء العتيق، وواضعا يدي في جيبي سروالي – لا لشيء سوى لأنني لا أستطيع أن أتحمل أشخاصا مثله فترة طويلة، أشخاصا لا يرون في أنفسهم القدرة على ارتكاب جريمة قتل، ولذلك يستبعدون أيضا قدرتي على ارتكابها.
قال لي:
إنني أفهمك تماما، أفهمك تماما! أنت ساخط على سويسرا التي استقبلتك بالحبس الاحتياطي، مفهوم، أعني: سخطك مفهوم، فمن المرارة أن ينظر المرء إلى وطنه من وراء القضبان …
ماذا يعني “الوطن”؟
قفز على سؤالي الذي لم يكن ثانويا على الإطلاق، وواصل كلامه:
ولكن لا تصعّب عليّ دفاعي. بعض الأقوال التي نطقت بها عقب اعتقالك، وصلت للأسف إلى الصحافة. لمَاذا التحريض؟ لمصلحتك، أرجوك الامتناع من الآن عن إبداء أي نقد تجاه بلدنا، الذي هو في نهاية الأمر وطنك.
ماذا قلتُ إذاً؟
الناس هنا حساسون للغاية.
هكذا رد عليّ بصراحة جميلة، ممتنعا في الوقت نفسه امتناعا واضحا عن أن ينطق بلسانه بأي ملاحظات تنتقد سويسرا، ثم تابع قائلا:
– حتى نظل في موضوعنا: لقد قرأت في الفترة الماضية كل الملفات، والآن، من لطفك، أخبرني بخطوط عريضة أين وكيف قضيت هذه السنوات الست الأخيرة …
هذا ما يسألني عنه في كل مرة. مع أنني أقسمت أنني لن أدلي بأي أقوال بدون ويسكي. سحبَ من حقيبته الجلدية ملفا ضخما، لا يستطيع المرء أن يقلب في أوراقه مجرد تقليب قبل أن يزيل المشابك التي تمسكه. ضحكت في وجهه. إنه متأكد من أن هذا هو ملفي، ولا أحد يستطيع منعه من قراءته طوال ساعات. وكأن الملل الذي يصيبني به يوما بعد يوم ليس نوعا من التعذيب!
قاطعته اليوم قائلا:
السيد الدكتور، لقد أتيت لتوي من المكسيك …
هذا ما تدعيه، أعرف.
قلتُ مكررا:
… لقد أتيت لتوي من المكسيك، وصدقني: إن الأضحية البشرية الشهيرة لدى “الأزتيك” – الذين ينتزعون القلوب البشرية من الأجساد الحية حتى يقدمونها قرابين للآلهة – هذه الأضحية لا شيء، مقارنةً بالمعاملة التي يلقاها الإنسان عند الحدود السويسرية إذا جاء من غير أوراق – أو بأوراق مزورة – لا شيء!
لم تصدر عنه سوى ابتسامة.
أنت تعترف إذاً، يا سيد شتيلر، أن جواز سفرك الأمريكي ليس سليما؟
اسمي ليس شتيلر!
بهدوء تام وكأنني لم أصرخ في وجهه قال لي:
أخبروني أنك من المحتمل – من المحتمل! – ألا تكون سوى أناتول لودفيغ شتيلر، المولود في زيورخ، نحّات، ومتزوج بالسيدة يوليكا شتيلر تشودي، مفقود منذ ست سنوات، وآخر محل إقامة في 11 “شتاينغارتن-غاسه”، وقد كُلفتُ …
بالدفاع عن السيد أناتول شتيلر.
نعم.
اسمي وايت.
لكني لا أستطيع توضيح ذلك له، حتى لو كررته مئات المرات. يسير حديثنا مثل أسطوانة غرامافون عندما تنزلق إبرة الجهاز في موضع معين دائما إلى المكان نفسه. يسألني:
لماذا، لماذا أنت لست شتيلر؟
لأنني لست هو.
ولم لا! لقد أعطوني معلومات.
وفي النهاية ألتزمُ الصمت. وقته المحدود هو خلاصي الوحيد من هذا الإنسان طيب القلب الذي يعتبر نفسه محاميا لي، ولهذا يشعر بالإهانة لأنني – وبعد أن قرأ الملف كاملا – لم أتعاون معه. وفي النهاية يحشر الملف في حقيبته الجلدية حشرا، وبلا كلام يحاول جاهدا إغلاق الحقيبة إلى أن ينجح، ثم ينهض، ويفحص ببصره ما إذا كان قد أخذ كل شيء، القلم الحبر والنظارة، ثم يمد يده ليصافحني، كلاعب تنس خسر المباراة، ويخبرني متى سيعود إليّ في اليوم التالي …
ملحوظة:
مقتنع هو ببراءتي. ما معنى ذلك؟ فجأة يخطر على بالي أن هناك شكوكا ما تحوم حول شتيلر، المفقود؛ ولهذا فإن لدى السلطات المحلية احتياجا ملحا للعثور على مواطنهم المفقود للكشف عن شيء ما.
يعد إصدار عمل جديد مترجم عن الألمانية بتوقيع المترجم القدير “سمير جريس” حدثا بارزا؛ هو يقدم هنا واحدة من أهم الروايات الألمانية المعاصرة “شتيلر” للكاتب السويسري “ماكس فريش” التي وصفت بأنها رواية استثنائية عن الإنسان الحديث وعلاقته المتصدعة مع الهوية
*المنشور هنا مقطع من رواية “شتيلر”-التي صدرت مؤخرا عن داري سرد وممدوح عدوان – بإذن من المترجم
————————–
عن «شتيلر».. مواطن ما بعد الحرب/ حسن داوود
من فور وصوله إلى سويسرا، بلده، يُعتقل الرجل المدوَّن في السجلات باسم ليوبولد شتيلر. السجن الذي سيق إليه كان مريحا، بل أنيقا ما جعل السجين، المنكر لشخصيته بزعمه أنه ليس ذاك الشخص، يسخر من الرفاهية المتاحة له. ما هو متوافر له في سجنه يجعله أكثر رفاهية مما لو أقام في شقّةٍ على نفقته، إضافة إلى حسن الإقامة، أتيح له أن يخرج من السجن لساعات، بل لليال، حيث أمكن له أن يجدّد علاقته بزوجته يوليكا، زاعما على الدوام أنه لم يكن زوجها في السابق، وأنه يبدأ علاقة جديدة مع امرأة لم يكن يعرفها.
حتى أنه صادق المدعّي العام رغم تمنّعه، هو السجين، عن الاستجابة لتحقيقاته، التي كان يجريها ذاك المحقّق بلطف وتهذيب شديدين. كل شيء جميل في السجن، وفي سويسرا أيضا التي يكرهها رغم ذلك، ويكره أهلها بسبب تعلّقهم بما يعتبرونه أصالتهم. إنهم يعيشون في ماضيهم الذي يقدّسونه إلى حدّ أن الحرث «إذا لم يكن يتمّ بالخيل، فإن الخبز لا يمنحهم إيّ شِعر». وهم، لأجل أن يبقى الماضي حاضرا في عيشهم أبقوا بيوتهم كما هي، دون السعي لأي تجديد. وهو يتساءل إلى أيّ مدى يمكن لمعماري سويسري أن يكون جسورا في رؤاه وهو يعيش وسط شعب لا يريد المستقبل، بل الماضي. ما كان ينبغي لهم، حسبه، هو أن يتجرأوا على مواجهة مهام عصرهم بالشجاعة نفسها التي تحلّى بها أسلافهم، «وكل ما عدا ذلك ما هو إلا تقليد وتحنيط».
وقد تعدّت سخريته من سويسرا إلى أمريكا، التي جعلتها نتائج الحرب العالمية الثانية حاضرةَ العالم، بديلا من أوروبا. لم يؤلّف أفكاراً أو نظرياتٍ عن هذا البلد الجديد، شأن ما فعل تجاه بلده، بل اكتفى بوصف مشاهد، ربما كانت الأكثر فكاهة وسخرية بين كل ما كتب في هجاء أمريكا، من ذلك مشهد السيارات في الزحمة، وهذا ما كان صعبا تحويله إلى سخرية مرحة وعميقة لولا قدرة الكاتب الفذّة، وكذلك مشهد الاحتفال الراقص والصاخب الذي يقيمه السود في إحدى كنائسهم. أما عن الحرّية المدّعاة، الحرية الجديدة على مثال البلد الجديد، فيقول: «هناك فرق في درجة العبودية وحسب».
على مدار صفحات الرواية التي نافت على الخمسمئة صفحة، لم يتمكن أحد، لا المحامي المدافع عن بطلنا، ولا المدّعي العام في قضيته، من ثنيه عن الادعاء بأنه ليس ليوبولد شتيلر. أما نحن، قرّاء روايته، فكان علينا أن نظل متردّدين حيال ذلك. بكفاءة نادرة أبقانا الكاتب ماكس فريش في تلك الحيرة بين الشخصيتين المختلفتين، بل بين قطبي الشخصية المنقسمة تجاه ما كانته وما هي ذاهبة إلى ما ستكونه، أو ربما يمكن الظنّ بأن صاحب الشخصيتين لا يريدهما كليهما. ذاك أن شتيلر مقفل على ماضيه، ولا يجد شيئا يأمله من حاضره.
دون أحداث دراماتيكية، ودون وقائع فعلية حيث ماضي شتيلر، بطل الرواية، إما متوّهم أو مشكوك بحقيقيته، أمكن للروائي أن يكتب كل هذه الصفحات دون أن يدفع قارئه إلى الملل.
ثم إنه، في ما خصّ ماضيه وحده، كان منقسما إلى أكثر من شخصية واحدة، فقد كان سكّيرا وساعيا في مكافحة الفاشية، وزوجا نصف ناجح ونصف فاشل، وهذا ما يجعل عودته إلى ماضيه الشخصي محالا، إذ إلى أي جانب من ماضيه يذهب. وإذ أُرجع في صفحات الرواية الأخيرة إلى ذلك الماضي، الذي لم يبق مما يمثّله إلا زوجته، فبالاستدراج من المدّعي العام الذي أصبح صديقه، وبالتهديد البوليسي المازج بين الفكاهة ورواية المطاردات الجاريين حول المبنى الذي هو فيه. ظاهريا لقد عاد شتيلر إلى نفسه، أو إلى زوجته الفاتنة، لكن بعد أن تحطّمت كل التماثيل التي كان نحتها في محترفه. كان راضيا بالبيت الزراعي نصف المهدّم الذي سيعيش فيه، مرة أخرى، مع زوجته الفاتنة، وبدلا من أن يعود إلى فنّه (النحت) راح يصنع أواني فخارية لم تكن بالجودة التي يكفيه عائدها لعيشهما.
تنتهي الرواية إلى أن تكون مأساوية على طريقة الروايات الرومنطيقية حيث يصيب المرض القديم، السلّ على الأرجح، يوليكا المرأة الأجمل كما يراها الجميع، بمن فيهم شتيلر نفسه. من تيارات روائية وفنية كثيرة صنع ماكس فيشر روايته الضخمة، التي رغم ذلك، كانت تسعى إلى الإضاءة على جديد لم يُرَ تماما بعد في عالم ما بعد الحرب. الغرام، الزواج والقرابة التي يمثّلها شقيق شتيلر في الرواية، وكذلك الصداقة، والخيانة، إلخ، كلّها تبدو وقد انزاحت عن التحديدات المعرّفة بها. السخرية التي بدأت بها الرواية، والتي قامت على المُفارق وغير العادي، كأن يكون السجن أفضل من البيت، وأن يكون المدّعي العام أرأف بالمحكوم من محاميه، وأن ترسم الشخصيات من خارج مرجعياتها التقليدية… وأن يكون ذلك معزّزا بأفكار نابذة لما قامت عليه قناعات البشر ومعتقداتهم، لم تفلح كلها في جعل العالم لعبة يُتلهّى بها. لقد اختتمت الرواية بحزن وموت يناقضان كليا تلك السخرية التي كانت لبطلها في ما سبق من الصفحات.
دون أحداث دراماتيكية، ودون وقائع فعلية حيث ماضي شتيلر، بطل الرواية، إما متوّهم أو مشكوك بحقيقيته، أمكن للروائي أن يكتب كل هذه الصفحات دون أن يدفع قارئه إلى الملل. يرجع السبب في ذلك، ربما، إلى الملاحظات المبدعة، والكشف العميق لمباعث السلوك البشري، اجتماعيا وفرديا، كما للسرد المسرع حتى ليكاد يسبق نهم القارئ الخائف دوما في قراءاته من ركود السرد أو تباطئه.
ولكي يمكن كتابة رواية بهذا الاتساع، أدخل الكاتب ما يشبه روايات إضافية على روايته الأم، بأن أعطى الشخصيات الثانوية ما يُعطى عادة لبطل الرواية الفرد. هكذا قرأنا، في مجرى حياة شتيلر وهواجسه وأفكاره، تفاصيل حيوات أخرى لأشخاص آخرين على شكل روايات قصيرة، أدخلت في النصّ، كما سرد حكايات، شبيهة بالحكايات الخرافية لم يكن من لزوم لها، وهذا ما جعل المستمع يردّ على راويها بقوله: «وما علاقة هذا بموضوعنا؟»
رواية «شتيلر» لماكس فريس، التي يعود صدورها إلى سنة 1954 نقلها عن الألمانية سمير غريس لداري «سرد» و«ممدوح عنوان للنشر» في 534 صفحة لسنة 2021
كاتب لبناني
لتحميل “ رواية شتيلر لـماكـس فـريـش” اتبع الرابط التالي