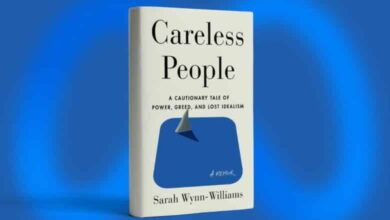كتاب يانوس… أن تأكل جَدَّكَ نَيئاً/ عمار المأمون

لا يمتلك كتاب “يانوس”، للعراقي محمود عوّاد، علامة تجنيس تقليدية، إذ نقرأ تحت العنوان “طقوس المرايا الضالة”، أي نحن أمام مُغامرة لا نمتلك سلسلة توقعات عنها، لا فكرة لدينا لا عما سنقرأ ولا ما سنجده داخل الكتاب من نصوص. لكن نقرأ في المقدمة ما يرسم لنا ملامح ما يُمكن أن نجده، فـ”الكتابة هي أن تعضّ لسانك سهواً”، ليستطرد بعدها عوّاد في الحديث عن “التهام لحم الأجداد” فيما يشبه “مانيفستو آكلي لحوم البشر”، لكنه يضع شرطاً للكتابة اليانوسيّة، مفاده أن على الفكر “أن يتذوق لحم الأسلاف بلسان خائف، بعد ذلك يفكر بالتهامهم”.
نص بدون مؤلف
المثير للاهتمام في هذا الشكل من النصوص والموقف الذي يتخذه عوّاد أنه لا يتبنى دور “المُؤلِف”، أي لا يؤدي دور من يجمع العناصر ويرتبها لكسر وحشتها والتأليف بينها بحيث تغدو “نصاً” ذا علاقات منسجمة داخله، بل نراه أقرب لمن “يلفق” الكلمة التي تتردد في نصوصه السابقة مراراً، أي يضع العناصر والأسماء والأحداث والأشكال لتجمعها علاقات ريبة وشكّ، الشعوران اللذان ينتقلان إلينا نحن القرّاء، فما تقع عليه أعيننا يصل حد المريع، يُذهب الروع، وأحياناً يهدد التقنية التي نقرأ عبرها، أي ترديد الكلمات بترتيبها المكتوب في الرأس لتذوقها أو فهمها جملاً وفقرات.
ضمن ما سبق تظهر تلويحات شعرية، فالتهام الماضي والأجداد ثم تغوطهم أو تقيؤهم، يتركنا في مستنقع من قيح وخراء، لكن ضمن تكويناته احتمالات من “جمال”، خصوصاً أننا لسنا أمام عملية تقليديّة، أي لا طبخ أو تأليف، بل التهام نيء، ثم معالجة في “الداخل” ثم إطراح، وضمن كل هذا، سخرية وتهكم، أو ربما كرنفالية دونيّة تنبذ الراقي والمهذب والمؤتلف، لتتبنى المنحط والدنس والمنتمي إلى معجم رابليه “الدونيّ”، حيث لا حقيقة سوى الجسد وفتحاته وما يتخللها، دخولاً وخروجاً.
كلمة طقوس في علامة التجنيس تحيلنا إلى شكل مسرحي، وهو ما نلاحظه في تدفق النص، هناك بقايا من مسرح يتآكل، حوار عقيم بين نيوتن وأينشتاين وأبونهايمر، الذين يتأملون القنبلة الساقطة من السماء والتي ستفني العالم، هذه القنبلة نشرت الجنون الحديدي بين البشر عوضاً عن أن يكون هبة من الآلهة، فحتمية النهاية التي شهدناها منتصف القرن العشرين هددت إدراكنا للمستقبل، وجعلتنا في موقف من ينتظر حتفه القادم، وهنا، تظهر ملامح غودو وزمنه المنتظر وعودته المتوقعة، لكن عوضاً عن مهرِّجَين (استراغون وفلاديمير) نحن أمام علماء يحدقون بالنهاية تهبط عليهم هي قادمة لا محالة، يتبادلون الخراء والشتائم والاقتباسات، فالقنبلة هي الإله الجديد، والخوف الجديد، والوعد المحتم بالفناء.
علماء ومتحذلقون
العلماء لا يتحذلقون كشخصيات المسرح، ولا يحاولون اكتشاف أوجههم وعلاقتهم مع مؤلفيهم كــأوديب وهاملت، بل يسلمون بحيرتهم، باحثين عن نشوة الجنس قبل موت لا فكاك منه، هي الرغبة التي يسعى إليها المحبط المتيقن من نهايته ولا جدوى انتظاره، ألم يرد استراغون وفلادمير شنق أنفسهما كي ينتصبا؟ في حالتنا، العلماء وآلهة الذرة الجديدة لا يواربون، هم يريدون النيك نهايةً، فكلهم/نا بشكل ما فتحات لابد أن تدخلها القنبلة/ النهاية.
أتأوّل هنا على “المرايا الضالة”، إذ يحضر أجداد المسرح أمامنا يتحاورون ويتباذؤون، تتداخل كلماتهم مع خراء الزمن، وهذر غودو، والفريد جاري، وهاملت وأوديب، فكلهم أسرى نصوصهم ورؤى الناس عنهم، وربما في طاعون أرتو حلاً لمشكلتهم، بالتالي وبسبب قدرة الطاعون على الانتشار، الخشبة أو المسرح يمكن أن يحضرا في أي مكان، مقبرة يتقاذف فيها أوديب وهاملت جمجمة كلاعبي كرة قدم، فردوس علوي تبول فيه الملائكة بوجه السماء ويعمّد فيه الفريد جاري بأيره الموتى، وهنا يتضح الالتباس الذي تسببه المرايا الضالة، هي لا تعكس صوراً متطابقة، بل أقراناً مختلفين، فكل من في المرآة ليس أنا، بل ذاكرة من مر ومن وقف، تتكاثف الذاكرة هذه حتى يفقد كل من يقف أمامها وجهه.
تسخر أشباح المسرح لدى عواد من الموت نفسه وأزمانه، فطائرة حربية في السماء ليست إلا غرضاً مدهشاً يمكن أن يسميها نيوتون ” جسداً بلا أعضاء” ، في إحالة إلى مفهوم جيل دولوز، وهنا يظهر مجاز شديدة القسوة، إذ تنفي القنبلة التي ترميها الطائرة العلاقات ضمن مكونات ما تصيبه، هي لا تفكك وحدته، بل تهدد إعادة تجمعه، وربما بعثه لاحقاً، ليصبح ما تحت الطائرة جثث تمتزج مع الخراب والغبار والشعر الرديء، لنأتي نحن بعد القنبلة /النهاية محاولين “تأليفها” دون جدوى.
لغة العواء الشعرية
نكتب بلغة شعرية لأننا ندخل مع عواد كابوساً، أو جنوناً لا جغرافيا له، هذا الجنون المتكرر ذكره في الكتاب ينفي العلاقات المنطقية بين الأشياء، أوديب مرآه هاملت، وغودو المُنتظر دوماً، نرى صورة نادرة له، نتأملها مصعوقين، أيمكن أن يكون هذا غودو المنتظر؟
يمكن أن نقول أيضاً إننا أمام نص مسرحي، بعض العلامات تشير إلى ذلك، لكنه في ذات الوقت، لا يعترف بأنه “نص”، أشبه بـ”سيرة ذاتية لفشل عرض مسرحي” وهنا بالضبط ما لا نمتلك عنه دليلًا، كيف يمكن أن يكون شكل عرض مسرحي فاشل، ألأن شخصياته غير مفهومة، أو نصه غير متماسك؟ لا إجابة واضحة عن ذلك، وهنا يمكن أن فهم النص النقدي الذي يورده عواد في الكتاب بعنوان “ضحايا المكان في العرض المسرحي”، فكل مكان، ولو في الذاكرة، يصلح لأن يكون مسرحاً، يكفي فقط تحرره من ثقله وتاريخه.
يحاول عواد أن يضرب في العين، يفقأها، يبول فيها، ينيكها، العين وما تحمله من ذاكرة ومعان سابقة، يبحث عن عين بدائية، عين تقرأ وتنظر دون أن تَألف ما تراه، هذه العين ربما للموتى أو المجانين، حفرة نقية من كل أيديولوجيا، نبصر منها ما لا نراه. ربما هذه العين مستحيلة ولا بد من خراب كي تُبعث، عين لا مقدس فيها ولا أمامها، وهذا ما يتضح في التعامل مع تاريخ المسرح، لا شفاعة لأحد، لأن القنبلة قادمة، الموت المحتم للجميع قادم، وباء، انفجار نووي، طاعون، أكلة لحوم بشر، لا أحد يبصر، ومن يبصر، يتأول شعراً بانتظار مخلّص ما.
نتلمس في نص معنون بـ”قديس القذارة” عن حضور مجاز الكاتب ككلب، ففي منتصف الليل الفردوسي “تجتمع كلاب المقبرة مقررة قراءة البيان الختامي للدفن” وكبير الكلاب يأمر كل واحد “أن ينبح حسب مفهوم الموت لديه”، ليهمس كبير الكلاب نهاية بالحقيقة في أذن الميت، مبشراً إياه بأن “الموت قطعة جبن في مصيدة الآلهة”، و”آدم كبير الفئران”، هنا يلتبس الأمر: من الكلب، ومن الكاتب وأي مما نقرأه هو العواء؟
رصيف 22