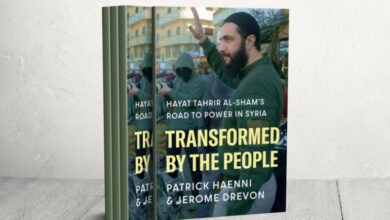ملاحظات على كتاب “رومنطيقيو المشرق العربي”/ راتب شعبو

ملاحظاتي على هذا الكتاب المهم يمكن اعتبارها نقد من الداخل، أي لا أواجه الكتاب برؤية خاصة بل أشير إلى ما يبدو لي نقاط ضعف وسط العرض المتمكن والواسع الأفق والاطلاع للكاتب، مع إضافة فقرة تحاول اقتراح ما يمكن عمله، وهو ما لا ينشغل به حازم الذي يستحق الكثير من التقدير.
في كتاب “رومنطيقيو المشرق العربي” للكاتب والصحفي اللبناني البارز حازم صاغية، الصادر عن دار رياض الريس للنشر والتوزيع (حزيران/يونيو 2021)، عرض متمكن للتيارات الفكرية السياسية في المشرق العربي (ما بين مصر والعراق) يغطي ما يزيد على قرن من الزمان، منذ انقلاب 1908 في السلطنة العثمانية حتى 2021، والتركيز على فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. الكتاب عرض نقدي يشدد على وجود علة مشتركة بين هذه التيارات على اختلافها، علة يسميها “الرومنطيقية”، ويدلل عليها من خلال سير شخصيات “رومنطيقية” وأحزاب وطروحات تمثل التيار المعين في الفكر أو في الممارسة السياسية. كما يتقصى سيطرة هذا النزوع في الشعر والأدب.
تواجه قارئ الكتاب صعوبة في الإمساك بمعنى مستقر للرومنطيقية، رغم اجتهاد الكاتب الذي يعترف على كل حال بصعوبة المهمة، في شرح مقصده منها، في الوقت الذي يشكل استقصاء ونقد هذه الرومنطيقية في التيارات الفكرية السياسية التي يتناولها الكاتب، الغاية الأولى له، كما يشير عنوان الكتاب. أي إن المشكلة هي غموض أو عدم الوضوح الكافي لما هو أساسي أو معياري في العمل الذي يجد الرومنطيقية في كل مكان، إلى حد يسأل القارئ نفسه هل يوجد تيار يمكن أن ينجو من هذه “الرومنطيقية” الواسعة.
يقول صاغية إنه “يعتمد معنى محدداً للرومنطيقية هو ضعف الصلة بالواقع، وأحياناً انعدامها، والتغلب تالياً على هذا الضعف إرادياً” ويضيف إن الكتاب “يطمح إلى أن يكون دفاعاً عن التطابق مع الواقع ومع العالم، والربط بين تغييرهما باتجاه أكثر ديموقراطية وتقدم وحداثة وعدالة بالإمكانات والأدوات التي يوفرها هذان الواقع والعالم” .
نفهم أن الكتاب يدافع عن وضع أهداف سياسية متصلة بالواقع، أي معقولة أو ممكنة، ومعقوليتها وإمكانها ينبع من توفر عناصر تحقيقها في الواقع الذي لا يقتصر على الداخل بل يشمل أيضاً الخارج. بكلام آخر يدعو الكتاب إلى تبني أهداف سياسية مشتقة من فهم واقعي للعالم، للمحلي كما للخارجي والكلي، وأن لا تغلب المشاعر “الرومنطيقية” على العقل العلمي التنويري، فلا تغلب القوة على المنطق ولا الإرادة على الممكنات. سوى ذلك فإن الفكر السياسي يكون منفصلاً عن واقعه أو “رومنطيقياً” ويكون أصحابه بذلك خطرين على أنفسهم أكثر من خطرهم على من يعادونه.
الحق أن جدية صاغية وحرصه على الواقعية أو ما يسميه “الذهاب إلى الواقع”، وسعة اطلاعه ومثابرته على النقد، تحرض الاحترام له ولعمله. من الملاحظ أن التوجه نحو نقد الفكر السياسي الذي كان سائداً في المشرق العربي، والذي يتميز بموقف عدائي من الغرب، وبتطلع يتجاوز الإطار الوطني (الذي فرضه الغرب علينا)، وبالتسليم في أن القوة هي السبيل الأول لنيل الحقوق، أصبح، بسبب ما انتهت إليه هذه التيارات من فشل، تياراً سائداً، على خلاف قول صاغية. أي إن الكتاب الذي نتناوله يندرج في تيار عريض لا يني يتسع، على خلاف شعور الكاتب بأنه يسير ضد التيار، وأنه ليس “على الموضة”. لاتساع هذا التيار النقدي أهمية كبيرة في محاولة تجاوز الفشل التحديثي المزمن في بلداننا.
لكننا، في هذا المشرق العربي، كيفما تقلبنا ومهما أبدينا من مرونة في القناعات ومن اتساع في النظرة، نجد الأبواب مغلقة وكأن “الانهيار المديد”، وهو عنوان أحد الكتب المهمة للكاتب، قدر على هذه البلاد. هل فعلاً مشكلتنا في ما سماه صاغية الرومنطيقية؟ ألم تتوفر لدينا قيادات أكانت في السلطة أو في المعارضة، تقبل من الواقع بأقله ولم تتمكن من شيء؟ فلا الجنوح إلى السلم أجدى، ولا الجنوح إلى القوة والحرب. لا الاستسلام أفادنا ولا قوة الإرادة. وها هو صاحب الكتاب يقول في مقابلة صحفية بمناسبة صدور كتابه هذا، أجرتها معه إندبندنت العربية في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2021: “لطالما صنفت نفسي متشائماً تاريخياً، قد يكون كلامي مزعجاً للبعض لكنني لا أرى أي بصيص أمل للتفاؤل” . إذن اكتشاف العلة، أو الاعتقاد بذلك، لا يقودنا إلى سبيل، ولا إلى تجاوز التشاؤم وانقشاع بصيص أمل. هل يعني ذلك أن العلة في مكان آخر؟ هل يؤكد ذلك استثنائيتنا المشرقية؟ ألا تضع هذه النتيجةُ البحوثَ موضع السؤال عن جدواها؟
هل من رومنطيقية في السلطة؟
لا تشكل السلطة، في الكتاب، حداً للتمييز بين “الرومنطيقيين”. الخميني وسيد قطب مثلاً ينتميان إلى الخانة نفسها، دون تمييز بين من هو في السلطة أو قل من يحتكر السلطة، ومن هو خارج السلطة أو في معارضتها. لا يكترث الكتاب لموضوع السلطة في عرضه، أي لا يعالج السؤال عن أثر الوصول إلى السلطة، على صاحب الفكر السياسي الرومنطيقي. هل يبقى المعارض الرومنطيقي كذلك حين يصبح صاحب سلطة؟ وهل تسمح السلطة لصاحبها أن يبقى منفصلاً عن الواقع أو رومنطيقياً؟
من طبيعة السلطة أنها تقرّب السياسي من الواقع، وتجعله يدرك مع الوقت ما هو ممكن، ذلك أن السلطة تمتحن الأفكار والسياسات لأنها تضعها في التجربة وتبين بالتالي جدواها من عدمه، فالسلطة مرغمة على أن تأخذ الواقع في الحسبان، إذا أرادت أن تستمر. الشيء الذي لا ينطبق على المعارضات، فهذه تظل أفكارها واقتراحاتها عالقة بعيداً عن التطبيق، وهذا ربما مما يساعد في تفسير “مزادوات” المعارضات على السلطات. دون أن يلغي هذا إمكان وجود سلطات مغامرة وفي انفصال عن الواقع، وغالباً ما يكون هذا أحد أعراض مرض الموت لهذه السلطات، ما لم تستعد صلة أفضل بالواقع، أي ما لم تشف من “رومنطيقيتها”.
يبقى مع ذلك مجال للتمييز بين السلطات حسب مشاريعها، بين سلطة تأبيد (سلطة الأسد في سورية، مثلاً) لا غاية لها سوى أن تحافظ على نفسها، فتصنع وتنشئ علاقاتها داخل المجتمع ومع العالم بما يخدم هذا المشروع، وبين سلطة ذات مشروع سياسي داخلي (تنمية) وخارجي (تحرير أو توحيد قومي)، مثالها سلطة عبد الناصر في مصر. القمع واحتكار السلطة سمة مشتركة بين هاتين السلطتين، وهما، في هذا الجانب، “واقعيتان” إلى حد بعيد. لكن الخلاف يظهر فيما عدا ذلك، فالرومنطيقية البعثية (الوحدة العربية، والاشتراكية) تحولت على يد الأسد الأب إلى أداة “واقعية” في تثبيت وتأبيد سلطته. أي إن الرومنطيقية البعثية ماتت في السلطة ولم تعد، مع الأسد المتمسك بمبدأ السلطة، انفصالاً عن الواقع. من نافل القول إن نخبة السلطة الأسدية لم تكن تقبض الكلام البعثي بكثير أو قليل، بل كانت تستخدمه، بوعي غير رومنطيقي، كستار أيديولوجي أو لغوي للممارسات التي جوهرها “الواقعي” تعزيز السلطة الأسدية ولا شيء آخر. على خلاف الحال مع الرومنطيقية الناصرية التي ظل لها في رأس عبد الناصر نبض حياة يتعلق بالتحرير وبأحلام سيطرة إقليمية على أساس قومي، قبل أن يطردها خليفته أنور السادات خارج القصر، إثر هزيمتين عسكريتين (1967 و1973)، ثم يتمادى بعدها في الواقعية.
وفقاً للمنظور النقدي العام الذي يحتويه الكتاب يبدو حافظ الأسد، لأنه تخلى بالفعل عن “القضايا الرومنطيقية”، وذهب، في تدعيم سلطته الداخلية والإقليمية، إلى الواقع لا إلى ما فوقه، أقرب إلى الصواب من عبد الناصر. وقد يكون صدام حسين نوعاً آخر يجمع بين الاثنين، بين كونه ديكتاتورياً عائلياً أبدياً من جهة، ما يفترض به أن يكون شديد الواقعية في حساب موازين القوى واعتبار المؤثرات الفعلية القائمة في الواقع من العشائر إلى الطوائف إلى نجاعة القمع وواقعيته، وبين كونه مفصول عن الواقع وساع وراء أحلام أوسع من حيلته على تحقيقها من جهة أخرى، ما انتهى به إلى السقوط والتحطم على صلابة “الواقع” الذي ابتعد عنه.
في بعض المعارضات أيضاً يمكن تلمس نوع من المجاورة بين واقعية شديدة ورومنطيقية عالية، وهذا يظهر بصورة جلية عند الإسلاميين، فهم إلى كونهم “أضعف الخصوم” في مجال نقد الرومنطيقية، كما يقول صاغية، إلا أنهم، فيما عدا انفصالهم عن الواقع من حيث تصورهم للمجتمع المأمول وارتهانهم لماض لا يعود، واقعيون وماهرون في التعامل مع واقع العلاقات الاجتماعية والاستثمار في الهويات “الواقعية” لاستخراج طاقة دعم سياسية يستندون إليها.
أما ماركسيو المشرق العربي، من جهتهم، فقد كانوا رومنطيقيين مرتين، مرة في تصورهم وهدفهم البعيد الذي لا يجد له سنداً في الواقع، ومرة في بناء ذاتهم وقوتهم التنظيمية والسياسية بالاعتماد على علاقات وقيم حديثة ضعيفة الحضور في الواقع.
ماذا عن الثورات العربية وما بعدها
يقول الكتاب إن الثورات العربية “شكلت فرصة لمغادرة الوعي الرومنطيقي وإنشاء مصالحة تاريخية مع الواقع مدخلها التفكير على نحو يتفاعل مع مجتمع ودولة محددين بعد طول الاستغراق في “الأمة العربية” و”الأمة الإسلامية” و”الصراع العربي الإسرائيلي”، وحلول الصراع مع الحاكم (الذي هو ابن جلدتنا) محل الصراعات الايديولوجية” ص19، وإنها “طرحت، للمرة الأولى منذ عقود، أفكاراً تتعامل مع الواقع كما هو”ص501. ويضيف “بيد أن هذه الفرصة هي التي انقضت عليها الثورة المضادة” ص19.
نفهم إذن أن “التعامل مع الواقع كما هو” يشكل بداية الخروج من الرومنطيقية التي هي “انفصال عن الواقع” يؤدي إلى تغليب الإرادة والقوة، وكأنها تفرض على الواقع ما لا يطيقه. لكن هذا القول يحرض الكثير من الأسئلة: لماذا يكون النجاح حليفاً شبه دائم للثورة المضادة؟ لماذا لا تكون الثورة المضادة “رومنطيقية” هي الأخرى وهي التي تقدس القوة، فضلاً عن أنها “تقف في وجه التاريخ” كما يفترض؟ لماذا تنجح غالباً الثورة المضادة التي اتخذت في الواقع شكل حركات إسلامية عنيفة، وهي حركات “رومنطيقية” بحسب الكتاب، فيما تفشل القوى الثورية التي بدأت في الثورات العربية تخرج من الرومنطيقية، بحسب الكتاب أيضاً؟ لماذا لم تستمد الثورات العربية قوة وثبات بعد أن خرجت من “الرومنطيقية” وذهبت إلى الواقع كما هو، وبعد أن خرجت من الصراعات الإيديولوجية إلى الصراع مع الحاكم؟ لماذا يسهل على الثورة المضادة أن تحشد، ليس فقط القوة المالية والعسكرية، بل وكذلك القوة الشعبية، وأن تخمد الثورة؟ لماذا يتحالف الواقع مع السلطات والثورات المضادة، ولا يتحالف مع المعارضات والثورات؟ ما هي الوجهة الكامنة في “الواقع كما هو”، هل هي في صالح الثورة أم الثورة المضادة؟ بكلام آخر لماذا لا نشفى من “رومنطيقيتنا” رغم الزمن ورغم التجارب ورغم قسوة الهزائم؟ هل المشكلة في “عقولنا” أم في “واقعنا كما هو”؟ هل تكمن المشكلة في أن واقعنا لا ينتج عناصر تجاوزه، فيبقى عنيداً على التغيير، ما يدفع رافضيه إلى “الانفصال عنه” وتغليب الإرادة وإعلاء شأن القوة؟
صحيح أن الثورات العربية كانت عاصفة على المستوى السياسي بسبب هذا الدخول الشعبي الواسع والمثابر في الصراع المباشر مع السلطات القائمة، لكنها لم تضف شيئاً على المستوى الفكري السياسي، وهي على هذا المستوى، وفي صرختها الأعلى “إسقاط النظام”، كانت أكثر “تطرفاً” وبعداً عن الواقع، من معظم المعارضات التي شهدتها بلدانها.
لا نظن أن من الدقة القول إن الثورات العربية أحلت “الصراع مع الحاكم محل الصراعات الايديولوجية”، فالصراع مع الأنظمة التسلطية الحاكمة على مدى عقود لم يكن صراعاً ايديولوجياً. هذه الأنظمة لا تسمح بصراع أيديولوجي أصلاً، إنها تسيّس أي خلاف كما تسيس أي نشاط، حتى لو كان على مستوى فني أو رياضي، وتجبر كل مخالف أن يخوض الصراع معها على المستوى السياسي، والأدق على المستوى الأمني. هكذا كان الحال قبل الثورات العربية، وكانت السجون مليئة وجاهزة لاتساع المزيد من أناس يختلفون “سياسياً” مع النظام، أو لمجرد أنهم ينتقدون الغلاء أو الفساد أو القمع … الخ، أو لمجرد أنهم “تفوهوا” على رموز السلطة ، وليس لأنهم يؤمنون بأممية شيوعية أو إسلامية ويعارضون فكرة القومية العربية مثلاً. بعيد عن الواقع اعتبار أن العقود السابقة للثورات العربية كانت عقود من صراع ايديولوجيات. أصلاً هل لهذا النمط من السلطات أيديولوجية يمكن مصارعتها إيديولوجياً؟ الأيديولوجيا تفترض هدفاً عاماً، والحال أن الأمن والديمومة الأبدية للسلطة يمتصان كل هدف آخر، إنهما “الأيديولوجيا” الوحيدة التي تحيل “الأفكار إلى ذرائع”، وتحيل أي أيديولوجيا أخرى للسلطة، إلى هيكل ضامر، لا فائدة كبيرة لمواجهته في صراع إيديولوجي.
لعل الكاتب يريد من الكلام عن “الصراعات الأيديولوجية” القول إن الصراعات السياسية السابقة على الثورات العربية كانت تخوضها قوى أيديولوجية، أي تفرض فكراً جاهزاً على واقع غير متقبل، أو تعطي الأولوية للفكرة الجاهزة على الواقع. لكن حتى في هذه الحال، تبقى المشكلة قائمة، فالسلطات القمعية أو سلطات الأمر الواقع، لا تسمح للصراع بأن يتطور بما يكشف محدودية أو عجز أيديولوجيا معينة. القمع الذي عانته الثورات العربية هو من النوعية نفسها التي عانتها القوى المعارضة السابقة على الثورة، هو قمع “أمني” مباشر، ليس له أذن تسمع الأيديولوجيا، إنه كتلة من الحساسية الأمنية، وبالكاد يمكن وصفه بأنه قمع سياسي.
كما لا نظن أن من الدقة القول إن ضعف مردود نضال الأحزاب الشيوعية أو الإسلامية أو القومية التي عارضت السلطات “المؤبدة”، نقصد التي لا يوجد أو لا تقبل بأي سبيل شرعي لتغييرها، ناجم عن رومنطيقية قومية أو أممية أكانت شيوعية أو إسلامية، إنه ناجم بالأحرى عن توظيف كل مقدرات الدولة لصد أي عمل سياسي معارض، أو أي نشاط مستقل مهما يكن، أكان كشفياً أو رياضياً أو فنياً أو أي شيء. الحضور الدائم للقوة الأمنية في المستوى السياسي، وجاهزيته الدائمة للتحول إلى حضور عسكري، يمنعنا من التفكير بصراع سياسي عادي، ويضعف مردود الصراع الإيديولوجي إلى حدود جعله أقرب إلى كلام في الهواء.
كشفت الثورات العربية، ولاسيما تلك التي طال أمدها، أن العنف هو الحاضر الأول والأخير في مواجهة الاحتجاجات، بصرف النظر عن محتوى الاحتجاج أو أيديولوجيته، عتبة القمع هي الاستقلالية عن النظام، أما التفاوت في منسوب قوة القمع هنا وهناك، فيعود إلى حسابات “واقعية” من جانب السلطات البعيدة كل البعد عن الرومنطيقية في مثل هذه الحسابات.
الأحزاب المعادية للإمبريالية أكانت شيوعية أو قومية والتي كانت في مواجهة مع السلطات “المؤبدة”، بقيت دائماً تحت خط الفقر السياسي، ليس بتأثير أيديولوجيتها أو إدمانها العداء للغرب أو انفصالها عن الواقع، بل بتأثير القمع المعمم الذي لا يسمح ولو باختبار الفكرة السياسية سواء من حيث مقبوليتها وملاءمتها أو من حيث فائدتها العامة. يحتاج الكلام الشائع عن أن مشكلتنا هي في الأحزاب الأيديولوجية وفي الفكر السياسي … الخ، إلى بعض التأني. الحقيقة أننا في واقع أدنى من أن تكون أفكارنا السياسية هي السبب الذي يفسر فشلنا. معظم الأحزاب المعارضة كانت تواجه الحاكم “في مجتمع ودولة محددين”، ولم تلك الأحزاب المعارضة التي كانت تعلي من شأن النضال ضد الامبريالية لم تكن تواجه الامبريالية أو “الغرب” من فوق رأس هؤلاء الحكام. على خلاف ذلك، فقد كان تنظيراً شائعاً في أحزاب اليسار الجديد مثلاً، يقول إن السلطات المحلية هي ركيزة الامبريالية، أي إن الصراع ضد الامبريالية هو صراع مع “الحاكم” المحلي. لم تكن الثورات العربية إذن هي من شقت سبيل النضال ضد الحاكم المحلي المحدد في مجتمع محدد، لقد كان هذا البعد “الواقعي”، بهذا المعنى، حاضراً في الصراع منذ عقود، سوى أن من تولاه في تلك الفترة الطويلة كان مجموعة من المناضلين الذين جرى عزلهم عن مجتمعهم بالقمع. ومع قناعتنا أن الفكر السياسي في هذه الأحزاب كان في الغالب أقرب إلى تركيبات ذهنية منه إلى الواقع، إلا أنه، حين يكون العنف حاضراً في الصراع وموجهاً ضد أي شكل من أشكال المعارضة، لا يمكن لوم السياسة والايديولوجيات بوصفها سبباً لفشل هذه الأحزاب.
لماذا نفشل بسبب “الرومنطيقية” فيما ينجح آخرون؟
الخط الآخر الذي لا يظهر في الكتاب هو التمييز بين الرومنطيقيين حسب نهايات أو نتائج “انفصالهم عن الواقع”. وهل ان رومنطيقية التيارات السياسية عندنا هي علة الفشل المزمن والمكرس. جمع أتاتورك مثلاً مع الرومنطيقيين العرب (فوزي القاوقجي، الملك غازي، ياسين الهاشمي، سامي شوكة، عبد الناصر … ) يغطي على ما يفيد التوقف عنده. لماذا تنتهي رومنطيقية الثورة السورية ضد الفرنسيين إلى الفشل فيما تنجح “رومنطيقية” أتاتورك؟ والسؤال نفسه يمكن طرحه فيما يخص النهايات المتباينة بين عبد الناصر وأتاتورك رغم حضور “التكوين الذاتي والرومنطيقي بقوة في الزعيمين”، كما نقرأ في الكتاب؟ يجيب الكتاب على السؤالين بالإحالة إلى “الفوارق الكثيرة التي ينبع معظمها من اختلاف الأوضاع والقوى الدولية المؤثرة”، أو إلى “تفاوت الواقعين التركي والعربي”.
الانفصال عن الواقع أو “ضعف الصلة بالواقع ثم التغلب على هذا الضعف إرادياً وذاتياً”، يمكن أن ينتهي إذن إلى النجاح، كما في حالة أتاتورك الذي نجح في إحياء تركيا بالقوة، أو إلى الفشل كما في حالة فوزي القاوقجي، بحسب الظروف والأوضاع. النتيجة التي يمكن الخروج بها، والحال هذه، هي إن الرومنطيقية صفة غير حاسمة في تاريخ الفكر السياسي، ولا يعتمد عليها في تفسير فشل أو نجاح مشروع سياسي. وربما يمكن القول إن “رومنطيقية” أتاتورك هي من أسباب نجاحه. يمكن القول أيضاً إن دولة إسرائيل نتجت عن مشروع رومنطيقي، بحسب مفهوم الكتاب، سواء من حيث دور الإرادة والقوة في فرض واقع أو بالأحرى خلق واقع، أو من حيث الشحنة النكوصية و”الوعد الإلهي” والبعد العاطفي، ولكن هذا المشروع نجح، فلماذا لا تنجح “رومنطيقيتنا”؟ وإذا اعتبرنا أن الدعم الغربي لهذا المشروع يفسر نجاحه، فماذا عن نجاح مشروع أتاتورك المعادي للغرب؟
يبقى، مع ذلك، السؤال: لماذا تمكنت الرومنطيقية في التيارات السياسية كلها على مدى عقود؟ أو لماذا لم ينتج فشلنا المتكرر تيارات سياسية أكثر واقعية؟ هل يوجد في واقعنا مولد دائم للرومنطيقية؟ لماذا لم ينجح دخول الناس إلى الميدان بالصورة التي عرضتها الثورات العربية، في كنس الوعي الرومنطيقي لصالح وعي واقعي ثوري، أي ينطلق من عناصر يوفرها الواقع ليغيره ويزيد من مساحة الحريات والمشاركة والعدالة فيه، فيما تمكنت ثورة مضادة “رومنطيقية” بسهولة أن “تنقض على الفرصة التي وفرها “الربيع العربي” لمغادرة الوعي الرومنطيقي وإنشاء مصالحة تاريخية مع الواقع”؟ بدلاً من كنس الوعي الرومنطيقي برزت وتمددت الدولة الإسلامية “لتغلق الدائرة”، بوصفها “الابتذال الأعلى للرومنطيقية”؟
ملاحظة استمرار الوعي “الرومنطيقي” وغزوه كل التيارات الرئيسية التي سيطرت في المنطقة، حتى في الثورات العربية وبعدها، يشير إلى أن العلة الفعلية تكمن خارج البنية الذهنية وتتحكم بها إلى حد كبير. في تفسير رومنطيقية اليسار ولاسيما “الجديد”، يقول صاغية: “الذين لا يزالون يشتقون الأفكار والسياسات من ذاك الماضي [ماضي الرأسمالية وشرورها] لا بد أن ينتهوا، حيال العجز عن تغيير الواقع الكبير المتمثل بالرأسمالية وقدرتها على التكيف، إلى لون من الرومنطيقية الغاضبة والجريح، حيث يتجاور رفض وعجز غالباً ما يترجمان نفسيهما في صياغات نظرية فخيمة”. الواقع أن الرفض والعجز الذي عانته أحزاب اليسار الجديد عندنا، كان رفضاً للسلطات القائمة وعجزاً عن تغيرها، أكثر مما كان رفضاً وعجزاً عن تغيير الرأسمالية. هذه الأحزاب اعتبرت حيازة السلطة السياسية الشرط اللازم لتغيير الرأسمالية، واصطدمت بعقبة تغيير السلطة قبل أن تصطدم بعقبة تغيير الرأسمالية. وكان هذا في الواقع حال التيارات الأخرى، غير المعادية للرأسمالية والتي لا ترى أن الانتقال إلى الاشتراكية هو سمة العصر، مثل التيارات القومية والإسلامية. العجز عن التغيير المحلي سواء بإسقاط سلطات قائمة أو بالنفوذ إلى السلطة، هو القاسم المشترك بين تيارات المعارضة السياسية، وهو عجز مستقل إلى حد كبير عن الأهداف الكبرى لهذه التيارات.
ما يتبدى للعقل من استحالة في تغيير واقع راسخ محلياً على شكل سلطات تستخدم كل ما للدولة من قوة مادية ومعنوية لحفظ أمنها وتأبيد ذاتها، وعالمياً على شكل تشابك مصالح كوني لا يتسع لطموحات شعبية، يغذي تطلعات راديكالية ويدفع للانفصال عن الواقع ذهنياً على شكل هروب إلى الأمام، هروب كان انتحارياً في كثير من الأحيان، سواء على شكل خروج عنيف على الواقع (مثل حالة الطليعة المقاتلة في سوريا نهاية السبعينات من القرن الماضي) أو على شكل جرأة سياسية انتحارية هي الأخرى (مثل رابطة العمل الشيوعي في سوريا والحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي في الفترة نفسها).
الغرب وإسرائيل والعرب، ضديات متبادلة
يوجد هم ثابت عند صاغية لا يكف عن معالجته في مقالاته كما في كتبه، على أنه في المقالات، المتحررة من ضرورة انضباط الكتاب في فكرة جامعة، يبدو أكثر نضارة استكشافاً لمداخل جديدة في التفكير، كما يلاحظ بحق الصحفي في المقابلة التي سبقت الإشارة إليها في إندبندنت العربية. الهم الثابت الذي نقصده هو تأثير تاريخ نظرتنا إلى ذاتنا وإلى الآخر، الغرب بصورة خاصة، على المصير الذي وصلت إليها مجتمعاتنا التي تبالغ “في الإفصاح عن خلاف واحد هو ذاك الذي يربط عرب المشرق بالخارج”، كما يشير صاحب “قوميو المشرق العربي” في مقدمة كتابه المذكور. ويتوسع صاغية في استعراض وشرح هذه الفكرة في كتاب له يحمل في عنوانه “الانهيار المديد”، الصورة العامة لهذا المصير. في هذا الكتاب الأخير يقول إن “مسألة المسائل [عندنا] هي العلاقة مع الغرب”، ويصف هذه العلاقة بأنها “علاقة ضدية” وهذا يقود إلى “استمداد التعريف الذاتي من تعريف الخصم .. فأبناء المنطقة هم “ضد” الاستعمار ولاحقاً الامبريالية ثم أمريكا بالتخصيص، إلا أنهم ليسوا على بينة مما هم عليه تحديداً” .
لا يمكن إنكار صحة هذه الملاحظة، ولكن يبدو لقارئ صاغية أنه لا يعطي أهمية كبيرة لدور “الضدية” الغربية (إسرائيل ضمناً) تجاه العرب، وتغلب عنده، فيما يخص واقعنا العربي، نظرة يبدو فيها الغرب كأنه جهة منفعلة تتحدد استجابتها وفق موقف الأطراف العربية منها، أكثر من كونه جهة لها سياسات وتدخلات تساهم بقوة في تحديد مواقف الأطراف العربية (نقصد أساساً التيارات السياسية المعارضة للأنظمة، لأن الموقف العام للأنظمة من الغرب هو في الغالب موقف متكيف في الأساس، أو يسعى إلى التكيف، مهما بدا “ممانعاً”). ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحاً فيما يخص الموقف من إسرائيل التي لم تنفع كل المحاولات التصالحية العربية والفلسطينية، على ما انطوت عليه من تنازل، في الحد من ميلها التوسعي والاستيطاني ورسم علاقة عادية معها.
يهجو صاغية التيارات السياسية “الضدية” وذات النزوع الحربي في علاقتها مع الغرب ومع إسرائيل، وهو محق في هجائه، ولكن لا يقود هذا إلى تحديد سياسة ملائمة. لا يجتهد الكاتب في السؤال: إلى أي حد يمكن رفع “الضدية” في هذه العلاقة؟ إلى أي حد يمكن لتيارات سياسية معارضة أن تكون متكيفة مع الغرب الذي يساند الأنظمة السياسية التي تعارضها؟ من هذه الزاوية، يبدو الأمر أكثر سوداوية أيضاً فيما يخص علاقة الفلسطينيين مع إسرائيل. العلاقة التي يصح فيها قول الشاعر “بكل تداوينا ولم يشف ما بنا”. لم تنفع التصالحية ولا الجذرية، لم ينفع النضال من الخارج ولا من الداخل. صحيح أن النضال الداخلي أثبت إنه أكثر جدوى، ولكن التجربة تبين أن قدرات النضال الداخلي تبقى تحت سقف منخفض، كما هي قدرة الثورات العربية أمام الأنظمة، في الحالتين اتجهت الأمور إلى العنف، أمام شراسة الدفاع عن النفس التي تبديها السلطات. وفي الحالتين تبدو المساعدة الخارجية حيوية، ذلك لأن السلطات قادرة على خنق النضال الداخلي غير المسنود بخارج. وفي حالة المساندة الخارجية، من الصعب على النضال الداخلي أن يخرج من هيمنة مسانديه وتأثيرهم على صورته وسياساته.
في مقال له في “الشرق الأوسط” بعنوان “درس قبرصي للبنانيين”، يقارن صاغية علاقة قبرص اليونانية وقبرص التركية مع علاقة لبنان وإسرائيل، ويقول: “”القبارصة اليونان يكرهون الحرب. لا يغنّون لها ولا يكتبون لها القصائد … المهمّ تجنّب العنف والقتال …. الحكمة المعتمَدة هي أنّ التغيير يحصل عبر الضغوط والمقاطعات والإجراءات السياسيّة والاقتصاديّة. ما يحصل عبر القتال هو التدمير فحسب” . والحال إن المشابهة بين العلاقتين تميل إلى تقليل دور العدوانية الإسرائيلية التي تغذي “الضدية” العربية، وتعطي قيمة زائدة للضدية المقابلة. لا نعتقد أن “الضدية” العربية سبب كاف لتفسير العدوانية الإسرائيلية المستمرة، هذا إذا ضربنا صفحاً عن العدوانية الإسرائيلية الأولى. ولا نعتقد أن المشكلة تكمن في حب الحرب أو كراهيتها. المشكلة في واقع التعدي المستمر أكثر مما هي في النفوس. هذا الواقع العدواني المستمر بطيف واسع من السبل والأشكال، هو ما يفسر صعود “الرومنطيقيين” وتراجع “الواقعيين”، وهو ما يفسر تراجع فكر المقاومة الحديث أمام فكر المقاومة “الإسلامية”. ربما لا ينبغي تحميل مقالة صحفية الكثير من التحليل، فمن الواضح أن صاغية يكتب تحت ضغط مستمر لحالة حربية محددة يشكلها “حزب الله” في لبنان، ويتحكم من خلالها بالكثير من الداخل اللبناني، ولكن في المقالة المذكورة ما يعرض بصورة جلية ما يبدو لنا أحد الخيوط الناظمة في الكتاب.
نضال مدني أو معارضة مدنية
الصعوبة القصوى في اختراق الواقع، والتباين الكبير بين وضوح الحق وبين القدرة على استرجاعه أو الحصول عليه، تشكل محرضاً أساسياً لكل أشكال الخروج “الرومنطيقي” على هذا الواقع. ولكن يبقى من المهم، وربما الأهم، تقديم اقتراح محدد لشكل الخروج الواقعي على هذا الواقع. كيف يمكن لنضال شعوب هذه المنطقة أن يكون مجدياً؟ كيف يمكن “إسقاط نظام” أو التحرر من نظام محلي بقوى محلية حين يكون هذا النظام جزءاً من شبكة مصالح عالمية تبدو كلية القدرة؟ وكيف يمكن لنضال محلي ديموقراطي أن يندرج في شبكة مصالح القوى الديموقراطية الكبرى؟ كيف يمكن للنضال الديموقراطي المحلي المحدود القدرات أن ينجو من بطش السلطات المحلية المدعومة من قوى مضادة للديموقراطية، إقليمية ودولية كبرى؟
ليس بعيداً عن الحقيقة أن كشف قصور التصورات السياسية بنظرة راجعة، أكثر سهولة من بناء أو اقتراح مخارج من الأزمة المزمنة التي تعيشها شعوب المنطقة، أزمة التهميش السياسي والانخفاض الحاد في مستوى المعيشة، وفي الحريات والكرامة، مع امتلاك السلطات القائمة وسائل حماية كبيرة تجعل من العبث محاولات تغييرها بالقدرات الذاتية للمحكومين.
يمكن القول إن التفكير في المجتمع المدني هو “تعويض عن نكوص سياسي أصاب المثقف العربي، وعن استقالة من العمل السياسي بعد عجز أو وهن ضرب الحالة القومية واليسارية في حينه” أي في تسعينات القون الماضي عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، كما يقول عزمي بشارة . لكن النضال المدني الذي نقصده ليس نكوصاً عن النضال السياسي، إنه جانب آخر من النضال. كما أنه من المهم تمييز النضال المدني عن المجتمع المدني بقدر ما يكون هذا الأخير متصالحاً مع السلطات السياسية القائمة، أو ذراعاً مدنية لمعارضة سياسية. النضال المدني هو بالتعريف عمل معارض واحتجاجي وصراعي، وليس عملاً مكملاً أو متمماً لنقص “خدماتي” ناجم عن تقصير السلطة أو عجزها.
نعتقد أن أحد مداخل الحل يكون ببناء آليات نضال مدني منظم ومستمر، لا تكون السلطة السياسية هدفاً له، بل يهدف إلى مواجهة النتائج المباشرة للاستبداد السياسي على مستوى حياة الأفراد، مستفيداً من تقنيات التواصل المتطورة؟ فبدلاً من راديكالية التفكير باستئصال الفساد من “الجذور”، على ما تخال المعارضة السياسية في بلداننا، يعمل النضال المدني على مواجهة الحالات واحدة واحدة عبر كشفها وتوثيقها والضغط لمعالجتها سواء بمحاسبة المرتكب أو رد الضرر عن صاحب الحق … الخ، أو ما يمكن أن نسميه “معارضة مدنية” . هذا النوع من المعارضة لا يمكن أن يكون رومنطيقياً، لأنه يقوم على تحقيق مصالح مباشرة ومحددة، وهذا لا يمكن أن يتم بانفصال عن الواقع، بل يحتاج بالأحرى إلى واقعية حية ونقدية.
المعارضة السياسية في النظام الديموقراطي، تشكل قوة ضغط ومراقبة على السلطة القائمة، وعليه فإن هذه المعارضة لا تكون جذرية، أي ليست مضادة للنظام، فهي جزء من النظام الذي يستوعب عملها المعارض من ضمن آلياته، أما في “المشرق العربي” فإن النظام السياسي الاحتكاري أو “الأبدي” يطرد المعارضة من النظام، وعليه تجد المعارضة نفسها مرغمة على طرد النظام من منظومتها، بالمقابل، أي تجد نفسها مدفوعة إلى الجذرية “الرومنطيقية”. على هذا تبدو “الرومنطيقية السياسية” صفة لصيقة بكل أشكال المعارضات السياسية في بلداننا. نعتقد إنه للخروج من الحلقة المفرغة المتجسدة في واقع لا يتغير وينتج تيارات سياسية “رومنطيقية” تعيد تكريسه، لا بد من التفكير بمعارضة مدنية، ليست بديلاً عن المعارضة السياسية، ولكنها أيضاً ليست فرعاً من فروعها، أي ليست ذراعاً مدنياً لمعارضة سياسية.
إذا كانت المعارضة السياسية في بلداننا مضطرة إلى أن تنظر إلى السلطة السياسية القائمة على أنها أساس ومنطلق كل الشرور التي تقع على الجماعات والأفراد، وترى بالتالي إن أي عمل عام سيكون ضعيف المردود، أو حتى سلبي المردود، ما لم يستهدف السلطة ويسعى لتغييرها، فإن المعارضة المدنية تعمل على خلق مقاومة شعبية ضد التعديات المختلفة على الأفراد، دون أي غاية سياسية محددة، ودون أي انحياز سياسي لصالح تيار دون آخر، والأهم ضد انتظار أي “خلاص سياسي” موهوم. لنفكر مثلاً بالنضال ضد التعذيب الذي تمارسه السلطات، مهما كان لونها، ضد معارضيها، وكل سلطة تجد المبررات الوطنية أو الإسلامية أو التقدمية لممارسته. هذا الموضوع تفصيلي ومستقل عن الانتماءات أو التحيزات السياسية ولكنه بالغ الأهمية ككثير من المواضيع المشابهة، ويمكن أن يكون مجال عمل مدني منظم، وأن يكون أكثر جدوى من عمل سياسي “جذري”، جربته المنطقة لعقود طويلة، ولم تجن منه سوى الخسائر.
نهاية
كالعادة في معظم ما يكتبه حازم صاغية، يستمتع القارئ بالعرض التاريخي الشيق والواسع الاطلاع وباللغة الحية للكتاب وبزوايا النظر التي تهز المستقرات من الأفكار، ولكن في النهاية، حين يحاول القارئ بذهنه أن يخرج من الدائرة وأن لا يكون “رومنطيقياً”، لا يجد له معيناً في الكتاب. فالكاتب يوسع طيف اشتمال الرومنطيقية السياسية، ويرى فيها علة ثابتة، دون أن يشير إلى أي تيار سياسي نجا منها، رغم أن الكتاب يبدأ في مقدمته بالقول إن “هذه الصفحات لا تقول إن “كل” الفكر والابداع السياسيين العربيين من صنف رومنطيقي”.
رابط المقالة