في أنّ الخارج أشدّ احتمالاً من الداخل/ حازم صاغية
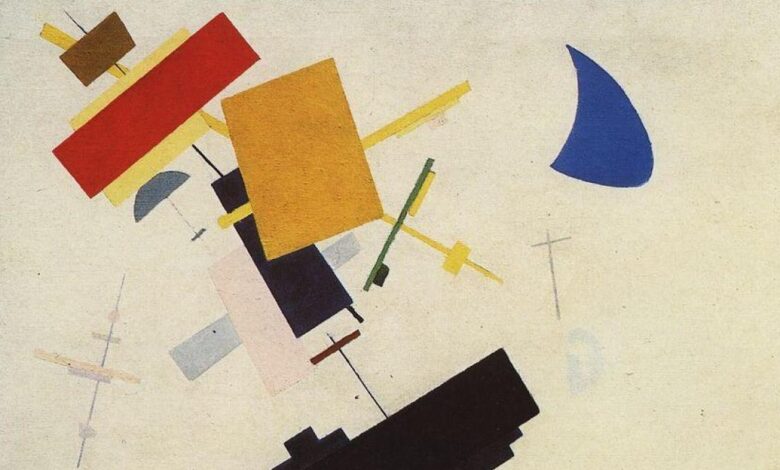
وذات مرّة كان السياسيّ والصحافيّ الراحل غسّان تويني قد أطلق عبارة صارت أشبه بشعار: «حروب الآخرين على أرضنا». والحال أنّ هذه العبارة التي تنتسب، عبر طريق التفافيّة، إلى سجال الداخل والخارج، لا تصمد أمام أيّ تدقيق أو امتحان جدّيّ.
فحروب اللبنانيّين خاضها لبنانيّون ضدّ لبنانيّين. صحيح أنّ غيرهم شاركوهم القتال، إلاّ أنّهم هم شكّلوا أكثريّة المقاتلين، وهم أعطوا لقتالهم عناوين لبنانيّة إلى جانب العناوين غير اللبنانيّة. فوق هذا، كانت هناك دائماً مسائل محلّيّة تلازم القتال الذي يخوضونه، بعضها يتّصل بالعدالة الاجتماعيّة وبعضها بالعدالة الطائفيّة…
لكنّ خطأ هذه العبارة – الشعار لا يلغي الفارق، ولو من حيث المبدأ، بين قتال لبنانيّ – لبنانيّ لم يتدخّل فيه الآخرون، وقتال تدخّلوا فيه. في الحالة الأولى، تكون الأكلاف البشريّة والاقتصاديّة أقلّ، كما يكون زمن الحرب أقصر، واحتمال الحلّ أعلى وأسرع.
يمكن تطبيق هذا المبدأ على جميع الأحداث الخلافيّة الكبرى التي عرفها البلد في تاريخه الحديث:
في 1952، وفي الخلاف حول عهد بشارة الخوري، اتّخذ النزاع شكلاً سياسيّاً بحتاً بين طرفين لبنانيّين. النزاع حُسم عبر ما سُمّي يومذاك «الثورة البيضاء»، وهي فعلاً تمكّنت من إزاحة الرئيس المذكور من دون إهراق نقطة دم.
في 1958، تداخلَ الخلاف اللبنانيّ – اللبنانيّ حول عهد كميل شمعون ودور «الجمهوريّة العربيّة المتّحدة» بعد أشهر قليلة على قيامها بنتيجة الوحدة المصريّة – السوريّة. النزاع كلّف عشرات القتلى واستمرّ بضعة أشهر. الحلّ جاء مَرعيّاً بتسوية أميركيّة – مصريّة مهّد لها التدخّل العسكريّ الأميركيّ في لبنان ردّاً على تدخّل «العربيّة المتّحدة». ربط الداخل بالخارج بدا محدوداً ومضبوطاً.
في 1975، اختلف الأمر بفعل عوامل ثلاثة على الأقلّ:
– ما هو لبنانيّ في النزاع أُلحق بما كان يُسمّى يومذاك «صراع الشرق الأوسط»، من الافتراق المصريّ – السوريّ بعد حرب تشرين/ أكتوبر 1973، إلى مبادرة أنور السادات في 1977، وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيليّ عام 1982.
– كانت منظّمة التحرير الفلسطينيّة الطرف المقرّر في الحرب سياسةً وتسليحاً، قبل أن يتعاظم الدور السوريّ منذ 1977، مرّةً بالصراع مع منظّمة التحرير ومرّة أخرى بالشراكة معها.
– كانت الأطراف المتدخّلة في الحرب، مباشرةً أو مداورة، كثيرة ومتكارهة، وكانت غالباً ما تسعى إلى تسوية نزاعاتها على أرض لبنان. العلاقات المسمومة السوريّة – الفلسطينيّة والسوريّة – العراقيّة والليبيّة – المصريّة إلخ… كلّها تجمّعت في بيروت.
في 1982، وبالاستفادة من المرحلة السابقة، استكمل الخارجيّ انتصاره على الداخليّ: الأوّل قويّ ومسلّح منحته الحرب العراقيّة – الإيرانيّة زخمه، كما منحه التحالف السوريّ – الإيرانيّ طريقه إلى لبنان. الثاني، في المقابل، هزيل، حطّمته الحرب والاحتلالات الإسرائيليّة والسوريّة ثمّ الحروب الداخليّة في العاصمة والضاحية والجبل. هكذا بُدّد ما تبقّى من إجماعات وطنيّة، وقُضي على احتمال استعادة سلطة مركزيّة ذات جيش قادر.
ولادة «حزب الله» قدّمت إسهاماً نوعيّاً لهذا المسار: لقد أعطت الخارج الإيرانيّ قوّته وغطاءه الداخليّين غير المسبوقين حجماً وفاعليّة. هكذا تمّ ابتلاع الموضوع اللبنانيّ وإلحاقه بصورة كاملة. الخارج صار هو الداخل. الداخل صار هو الخارج.
في هذه الغضون جرت محاولتان لاستنهاض الداخل، أو لإعادة اختراعه. 14 مارس (آذار) 2005 كانت الأولى. 17 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2019 الثانية. الاثنتان فشلتا لأسباب ذاتيّة وموضوعيّة كثُر التطرّق إليها.
إذا راجعنا هذا المسار منذ 1952 لاحظنا طابعه التصاعديّ في ما خصّ الخارجيّ، وضموره المتنامي في ما خصّ الداخليّ. عوامل عدّة خدمت الوجهة هذه: الحرب الباردة انتهت مخلّفةً فلتاناً كونيّاً ليس من ضابط له، والهويّات انفجرت على نطاق عالميّ، ثمّ باشرت الولايات المتّحدة، بعد حرب العراق في 2003، الانسحاب من المنطقة. وإذ أخفقت ثورات «الربيع العربيّ» ووعودها السخيّة، ترسّخت الدولة الإيرانيّة بوصفها واحدة من أعتى قلاع الهويّة ذات الوقود الشعبويّ – القوميّ في عالمنا المعاصر. إلى ذلك بات العالم أشدّ تداخلاً، وأشدّ تدخّلاً، ولم يعد لبنان قرية كبيرة كما كان في 1952، قريةً همومها خاصّة بها لا تعني سواها.
هل يمكن، والحال هذه، الرهان على داخل مجفّف تغيّره انتخابات نيابيّة لم تغيّر شيئاً من قبل؟
السؤال هذا لا ينطوي على جواب قطعيّ لمصلحة التعويل على الخارج. إنّه فقط يؤشّر إلى الوجهة الأغلب. أمّا أن يكون ما يأتي من الخارج حلاًّ، في ظلّ هذا العدم الداخليّ، فتلك مسألة أخرى.
الشرق الأوسط




