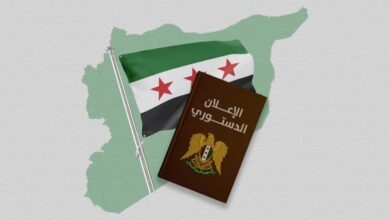“المزرعةُ السورية العجيبة”.. بهذه البساطة تماماً/ عبير نصر

لم تكن رواية “مزرعة الحيوان”، وهي أشهر أعمال جورج أورويل، روايةً بالمعنى الحقيقيّ، كانت خرافة أسطوريّة على لسان حيواناتٍ تعمل بجدّ ليلاً ونهاراً. تثور، في النهاية، على صاحب المزرعة المستغِلّ. لكنّ قائد الثورة “الخنزير” سرعان ما خانها، بعدما رفع شعاراً أصبح من الأقوال الإنكليزيّة الشهيرة: “كلّ الحيوانات متساوية، لكنّ هناك حيوانات أكثر مساواة من غيرها”. تبدو هذه المقولة فلسفية جداً، ومُوغلة في التجريد، ولكن بمجرّد أن نترك وراءنا تنظيرات العلوم الإنسانية والتاريخية ونتجّه إلى الواقع السوري، تبدو الجملة مقنعة ومفهومة تماماً. على هذا وببساطة، وبفكرة هذه الرواية الثورية، يمكن اختصار المشهد السوري اليوم: “بينما يموت الموالون برداً وجوعاً، يقيم وزير داخلية النظام السوري حفلَ زفافٍ أسطوري لابنته، كلف مئات آلاف الدولارات. الوزير نفسه كان يشرح قبل ساعاتٍ من الحفل، وبنبرةٍ بكائية مؤثرة، آليةَ رفع الدعم الحكومي عن ملايين السوريين الجائعين. بدورها، بثينة شعبان، المعروفة عموماً بلقب “سيّدة الصمود”، ترسل ورداً إلى حفل الزفاف مع ابن أحد ضحايا إجرام النظام السوري”.
بهذه البساطة تماماً، أسقطت الثورة السورية كلَّ الأقنعة، وصار لزاماً أن نعترف أنّ القهر السوري لم ينجم من فراغ عدمي، ولم يتخلّق من تفاعلاتٍ كيميائيةٍ جرت في كوكب آخر. وبالاطلاع على أدبيات الحياة السياسية السورية منذ الاستقلال وحتى وقتٍ قريب، يبرز الحضور القوي والمتكرّر لمفهومي الأمّة والهوية، من دون أن يعني ذلك الاتفاق على تعريفهما. حيث يبدو مفهوم “الأمّة السورية” من أبرز المفاهيم التي جسّدت إشكالية وعي السوريين بهويتهم، وهو ما قاد بالضرورة إلى المشهد السوري الحالي. تعزّز سوداويته استفزازاتٌ عدّة، كتحليلِ بشار الأسد الوضع الراهن في حوار جرى أخيرا مع صحيفة الثورة، الموالية له: “إن الشروخ داخل مجتمعاتنا، والتي نرى نتائجها الآن، بدأت مع نشأة الإخوان المسلمين، وتعزّزت بعد الاستقلال من خلال الدور السيئ الذي لعبوه في عدد من الدول العربية ومنها سورية!”. ويؤكد فقدانَ الأمل بالخلاص تصريحٌ منفصم آخر لوالد زوجة بشار الأسد، الذي نفى وجود أيّ ضحايا للعمليات التي تنفذها قوات النظام بدعمٍ مباشرٍ من الحليف الروسي. وعندما سُئل عن شعوره حول الإصابات المروّعة التي تسبّب بها زوج ابنته، أجاب الأخرس متعجّباً: “أيّ أطفال؟ أنا لم أرَ أيّ أطفال يُقصفون!”..
هذا يدفعنا باتجاه التسليم أننا لسنا في بلادٍ تشبه غيرها من البلاد، إنما نقف في مواجهةِ مزرعةٍ قائمة على المفارقات العجيبة. وعلى هذا سنسلم، تجاوزاً، بأنه لا غرابة، مثلاً، في استقبال الرئيس الروسي، بوتين، نظيره السوري في مقرّ القوات الروسية بدمشق، بينما الأخير هو صاحب المكان. ولا غرابة أيضاً في عدم وضع أي صورة للأسد، أو عدم وجود العلم السوري في المقرّ، لكننا لن نستطيع تجاوز منظر كرسي وزير دفاع النظام السوري الذي كان صغيراً وأخفض من البقية بشكلٍ مقصودٍ ومهين!. ولن نستطيع غضّ النظر عن مقطع فيديو أظهر ضابطاً روسياً وهو يمنع الأسد من اللحاق ببوتين وسط تجاهل الأخير، خصوصا أن القاعدة العسكرية التي يزورها الأسد هي حميميم السورية، وإن كانت تستخدمها القوات الروسية. بينما تأتي، وبكل سذاجةٍ مضحكة، إعلاميةٌ من جماعة مطبّلِي الطاغية، لتكشف أنّ الرئيس بوتين استشار الأسد قبل مهاجمة أوكرانيا!
أيّ تبجّح هذا، وأيّ نذير شؤمٍ مرعبٍ ألا يجد وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، في المقابل، وبعد عشرات الاعتداءات الإسرائيلية، حرجاً من تحذير إسرائيل من “التمادي” في شنّ الضربات الجوية، مشدّداً على “ضرورة عدم اختبار صبر وإرادة سورية، لقدرتها على الردّ في أية لحظة!”، حسب تعبيره. على المقلب الآخر، أيّ توهم وأيّ هلوسة اعتبار النظام السوري أنّ ما يجري في البلاد ليس سوى مؤامرة كونية ضد السلطة، وأنّ العالم بقضّه وقضيضه يتّحد للنّيل منها؟ أو حين يعلن غير مسؤول سوري أنّ الدول الغربية إنما تعزل نفسها ليس إلا، حين تفرض عقوباتٍ على سورية، كاظماً غيظه مما سبّبته هذه العقوبات من ضعفٍ وتهتكٍ اقتصاديين. وأيّ انفصامٍ عن الواقع، حين يتجرأ نظامٌ توغل عميقاً في الفتك والتنكيل بالسوريين، على تناسي ما ارتكبته أيديه الآثمة، ويندفع مثلاً إلى التنديد بمقتل المواطن الأميركي جورج فلويد، بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه، وأيضاً بالاعتقالات التي جرت في غير مدينة أميركية ضد المتظاهرين، ويعتبر ذلك كبرى الكبائر، وأنّ من يصمت عنها يخون إنسانيته؟!.
وربما ما سأقوله بثقةٍ مطلقةٍ هنا إنما سرد رؤيةٍ خاصة في سياقٍ أكثر عمومية: إذا شعر السوريون بالموت يتربّص بهم في كلّ مكان حتى في أسرّتهم صدِّقهم. وإذا قال لك سوريٌّ إن زوجة هانيبال القذافي ستقتله، وهي التي دهست عناصر شرطة في دمشق على خلفية مخالفة قامت بها، ليقوم بحمايتها أحد ضباط النظام قائلاً “هذه عندي”، فصدِّقه!. وإذا سمعت أخباراً قاهرة من قبيل: “العثور على طفلةٍ رضيعة في الشارع بدأت القوارض في التهام وجهها قطعة تلو الأخرى قبل أن يجدها أحد الأشخاص.. أو طفلة لاجئة تتمنى في العام الجديد خيمة، مجرّد خيمة”، كذلك صدقها. فأنت حكماً في سورية، بينما يتعرّض 80% من شعبها لاختيارات صعبة، بل ومصيرية، مثل الاختيار بين سداد العلاج الطبي لأحد الأبوين أو توفير المال من أجل وجبةٍ للأطفال!. وهناك على الطرف الآخر تنتشر صورٌ مسرّبة من حفلاتٍ باذخةٍ أقرب إلى الإنتاج السينمائي، التي توثق تسابقاً محموماً بين العائلات الثرية على من يقدّم الأفضل بأساليب أسطورية ومشاهد خيالية.
نعم، في سورية فقط ستجد فقراء يصطفّون داخل أقفاص معدنية للحصول على الخبز أمام الأفران، لكن مجرّد المرور مصادفة قرب شركة “إيماتيل” للاتصالات، ورؤية طابور انتظار آخر إصدارات الهاتف الذكي، يدفعهم إلى التسليم بأن الثقافة الوحيدة التي يحتاجونها اليوم للنجاة هي ثقافة الطوابير، متناسين أنّ ما ينتظرونه ليس هاتفاً يبلغ سعره ملايين الليرات السورية، إنما ربطة خبز بمائة ليرة وحسب!.. وما بين الفقر المدقع والثراء الفاحش، ثمّة قفصٌ حديدي يختصر الأزمة السورية منذ سنين. إنه الخوف الذي كبُر معه السوريون. لذا ترى حياتهم تمشي بتلكؤ فوق أشواك القهر والفقر. في بلاد الخيام وداخل أسوار السجون والمعتقلات. في المدن المنكوبة والمحاصرة، وتحت رحمة نظامٍ سحق فردية الإنسان السوري، ولم يبالِ به ولا بآلامه وأحلامه، إنما وظّفه كترسٍ في آلة عنفٍ عملاقةٍ في سبيل قضايا لم يخترها ولم يفهمها. وعليه، نجزم أنّ السوريين وحدهم من بين شعوب الأرض يموتون في هذه “المزرعة العجبية”، من دون أن يخلّفوا جثثاً.
وبهذه البساطة تماماً، أجزم أيضاً أن ثمّة دلائل تفصيلية تكاد لا تُعد لكثرتها، يثبت كلّ منها أنّ تحقق الأمة السورية بهويتها الصرفة، وبسلطة ذات شرعية في كل مناطق البلاد، صار مستبعداً للغاية في الأفق القريب، وأنّ السوريين، على مختلف حالاتهم، مهجرين أم في الداخل، مُجبرون على التعامل مع هذا الواقع المؤلم إلى أمدٍ طويل، طال جيلاً كاملاً منهم، وربما يطول لأجيال كثيرة قادمة.
العربي الجديد