الترجمةُ قراءةٌ / فرانسواز فيمار
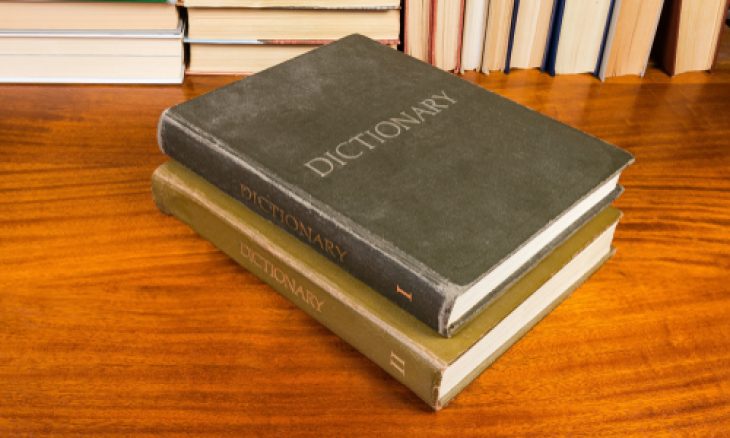
ترجمة عزيز لمتاوي
في عصر العولمة وحاجة الناس المتزايدة إلى التواصل، أضحت اليوم ترجمةُ أي نص أمراً مُلِحّاً، سواء أكان النص علميا أم تقنيا أم ثقافيا. وتُعَدُّ لعنةُ بابل مصدرَ سعادتنا، كما أن الله يُعتبَر، بالنسبة إلينا، معشر المترجمين، أقدمَ من منحنا العمل وأعظمَه، ولهذا السبب نتوجه إليه دائما بالشكر والامتنان.
تتضاعف مدارس الترجمة، بل نخترع آلات للترجمة آملين أن تُعوِّضَ عقلنا في يوم من الأيام، دون أن نُدخل في حسباننا أن الآلة لا يمكنها أن تمتلك متخيَّلا، كما لا يمكنها إدراك معنى السياق ولا معنى الإيحاء، ثم إنها لا تتوفر على ملكة الإبداع.
ومع ذلك، عندما نتحدث بإسهاب عن الترجمة، فإن القليل من الناس من يدرك بالفعل كيف تشتغل، وما أنماط العمليات التي تستدعيها في ذهن المترجم.
إني أرى فيها أحدَ الأنشطة الثقافية الأكثر صعوبة لأنها تتطلب، في الصورة المثالية، ذكاء عميقا، إن لم نقل شموليا، لإدراك تعقيد النص، كما تتطلب حساسية فنية كبيرة، وشعورا قويا بإنكار الذات والرغبة في الانفتاح على الآخر. باختصار، إنها تتطلب امتلاك جرعة قوية من التسامح، وحتى نبقى في السجل الديني، تتطلب حب المترجِم لجاره. يعلم الله بدقة، بعد كل شيء، السببَ الذي من أجله فرَّقَنا على طريقة بابل: لقد أَجبر الإنسان على الابتعاد عن أصله حتى يتقبل الغريبَ في اختلافه عنه.
سيرورة الترجمة
الترجمةُ قراءةٌ؛ أردت بهذا العنوان، المستفز بعض الشيء، أن أؤكد جانبا ما زال مجهولا في سيرورة الترجمة. تتجلى هذه السيرورة في لحظتين: لحظة التَشَبُّع ولحظة إعادة البناء. لقد شكلت اللحظةُ الأخيرة موضوعَ دراسات عديدة أضحت اليوم مواضيعُها تقريبا مبتذلة، وأُفكر هنا بالخصوص في مفهومَي: الأمانة والخيانة. يَقبل العالم كله في يومنا هذا أن الترجمة هي خيانة بالتأكيد. لكن القول، من ثمة، إن المترجم هو الخائن، فهذا يشكل خطوة كبيرة ليس من الموضوعية تجاوزها، لأن الذي يقول إن المترجم خائن، يعني بهذا حضور إرادة الخيانة حضورا واعيا لديه، في حين أن خيانة المترجم هي خيانة يُجْبَرُ على القيام بها. إنها مفروضة عليه.. إنها تعذبه ما دام هدفه الأول هو أن يكون أمينا في إعادة بنائه لما يُتَرْجِمُهُ. يوجد بالفعل مترجمون غير أكفاء يخونون لعدم حذقهم المهنة، فَلنُبعدْهم.. ولنتحدثْ منذ الآن عن المحترفين فقط.
ما الذي يدفع المترجمين إلى الخيانة بالقوة؟
إن أداةَ المترجم هي لسانه الذي يُرَوِّضُهُ ويُكَيِّفُهُ ليخلق بواسطته شكلا أدبيا؛ والحال أن هذا اللسان يسكن – ومعه ماضيه وحياته الحاضرة ومرجعياته المتعددة – أجزاءَه القصية التي ليست أقل أو أكثر نقاء من ثقافة نقية. هناك شعوب بالكاد توجد عندها كلمة مطر، وهناك شعوب أخرى تحضر لديها هذه الظاهرة بشكل مستمر ومتنوع، ويُعَبَّرُ عنها بعشرات الطرائق. لنأخذ اللسان الإنكليزي الذي يتميز فيه الصرف بثراء كبير، حيث يتم التعبير عن الزمن والمدة بدقة كبيرة، في حين يتوفر اللسان الألماني، وخلافا لِلِسَانٍ غني بهذا الشكل، على استعمال فقير للزمن. كيف نجعل الفروق الدقيقة لِلِسَانٍ معين فروقا في اللسان الآخر الذي يفتقر إلى الأدوات الملائمة. في اختصار، في كلمة واحدة كما في مئة، يَعكس اللسان نظرةً إلى العالم. أنْ ننقل هذه النظرةَ إلى لسانٍ آخرَ يرى الأشياء بطريقة مخالفة، فهذا يُشكل تربيعا للدائرة. سيكون المترجم إذن خائنا بالقوة. إنه ليس سوى لعبةٍ طيعة في يد لسانه الذي يهيمن عليه ضدا على إرادته. إنه داوود الصغير أمام جالوت ثقافته. وهناك، من وجهة أخرى، سبب خطير، بل مقلق أيضا، تكون معه الترجمة خيانة بالقوة: إن لسان الوصول، اللسانَ الأم، يَمُدُّ في الغالب الجسورَ لتدفق الإلهام.
لقد سبق أن قمت بهذه التجربة بحيث ترجمتُ ذاتي. كانت تبدو لي هذه المهمة سهلة للوهلة الأولى، لأنني كنت أعرف، أفضل من أي شخص آخر، ما كنت أرغب في قوله. في الواقع، وأنا أريد التعبير عن نفسي بلسان آخرَ، كان تفكيري يتخذ مَنحى مغايرا تماما. لماذا؟ دون شك، بسبب عادات ومرجعيات ثقافية مختلفة، وقد يكون أيضا بسبب جمهورٍ، هدفٍ آخرَ يَتَحَتَّمُ عَلَيَّ أن أُلْفِتَ انتباهه إلى بعض العناصر، وأن أتخلى عن بعض التدقيقات التي لم تَعُدْ ضرورية، والتي أعرفها أيضا.
قبضة اللسان
إن أَيَّ لسان هو بمثابة مِشَدٍّ. إنه يرهن الفكر بكليشيهات، إن لم نقل بتَوَتُّرَاتٍ، ويتأتى ذلك بالكلمات والتركيب والموسيقى وبعض العادات المتأصلة، ثم إن الشاعر لن يهدم، دون أي سبب، كل ذلك، ويقلب اللسانَ رأسا على عقب لكي يتمكن من بلوغ اللسان «الملائكي» الذي كان والتر بنيامين يتحدث عنه؛ ذلك اللسان الذي يتخطى حدوده الخاصة في اتجاه تأسيس لغة كونية. يمكننا توضيح قبضة اللسان على سيرورة الفكر والتعبير، متوسلِين بصورة مادية ورمزية عزيزةٍ عليّ: إنها المتعلقة بإعادة بناء صورة رخامية في مادة أخرى، لنقل الخشب.
يصطدم النَّحات الذي يحاول، بواسطة مبرده، إعادة إنتاج الصورة على الخشب، بالمُشكِل نفسِه الذي يصطدم به المترجم. إن الخشب الذي يعادل لسان الوصول مختلف جدا عن الرخام الذي يرمز إلى لسان الانطلاق: إن الخشب يُحْدِثُ أثرا آخر، وله رائحة مختلفة، ويوقظ مشاعر مغايرة.
يُدرك النحات، منذ البداية، أن صورته ستثير مشاعر مختلفة، ألن يكون ذلك بسبب هشاشتها الكبرى؟ إنه في الوقت الذي يحاول فيه مثلا احترام مُنْحَنى كَتِفِ الصورة الأصلية، فإن عروق الخشب لا تسعفه، ويجب أن يأخذ بالاعتبار الآتي: إذا ما استمر في التمسك برغبته في احترام الأنموذج، فإن الخشب سينكسر. إنه مُجبر على الخضوع لعروق الخشب وإعطاء الكتف شكلا آخر رغم عزيمته القوية وحرصه على أن يكون أمينا. ستكون صورة الخشب، في نهاية المطاف، مختلفةً جداً إذن عن صورة الرخام. ينطبق الشيء نفسه على الترجمة، إنها إذن إعادة كتابة» قسرية» بما أن المترجم مُكرَهٌ على الخضوع للسانه، والامتثال لمتطلباته التي تُفصِح عن مقاربة أخرى للأشياء، على المترجم أن يكون أيضا أمينا للسانه الخاص؛ فهو يُعَدُّ، بهذا، هَدَفِيًّا كما برهن على ذلك وفسره جيدا جان روني لادميرال، لا مَصْدَرِيًّا حريصا، خلافا لذلك، على التمسك الحرفي تقريبا بنص-الانطلاق على حساب قُراء الترجمة. هذا إذن ما يخص المرحلة الأخيرة من سيرورة الترجمة، مرحلةِ إعادة البناء التي دُرست بشكل مستفيض، أما المرحلة الأولى، أي مرحلة التَشَبُّع، فهي غير معروفة كثيرا.
مرحلة التَشَبُّع
أرى، مع ذلك، أن هذه المرحلة التمهيدية – الإعدادية للعمل الإبداعي هي الركيزة الأساس لإعادة الخلق. بِمن ينبغي على المترجم أن يَتَشَبَّعَ؟ بالمؤلف؟ بشخصية هذا الأخير؟ بالتأكيد لا. إننا لا نترجِم مؤلِّفا، وإنما نترجِم نصا. ولا وجود دائما لتطابق بينهما، بل إنه غير وارد البتة. يمكننا أن نُحب نصا معينا، ويبدو لنا رفيعَ المستوى، ونلاحظ أنه أُنتج من قِبل شخصية لا تشبهه بالكل أو تشبهه بعض الشيء. إن الأمثلة على ذلك متعددة، بحيث نفكر في سيلين على سبيل المثال. ومع ذلك، يوجد، في بعض الحالات، تطابق تام بين الكاتب والإنسان. لقد كنتُ محظوظة حيث كان كَاتِبَيَّ إرنست بلوخ وجان أميري يتكلمان مثلما يكتبان، كما أن سيرتهما الذاتية كانت مطابقة لأفكارهما ومُثُلِهِمَا. ويذهب ألبير بنسوسان، المترجم الفرنسي لكابريرا إنفانتي، إلى أبعد من هذا الحد: يختلط عنده التَشَبُّعُ بالاستيعاب. بنسوسان يُحب أن يحكي كونه تقاسمَ، لعدة أشهر، حياته اليومية مع مؤلِفه أثناء كتابة هذا الأخير لنصه الذي كان ألبير يَشْرَبُهُ من المصدر، على حد تعبيره، ويُعيد خلقه طريا، كما كان يُحب التأكيد على كونه يُقاسمه حياته اليومية، كان يأكل ويشرب وينام ويخرج صحبته. يتعلق الأمر هنا، دون شك، بحالة نادرة تعكس نزعة الانجذاب نحو الآخر بهدف الاستفادة منه إلى أقصى الحدود، غير أننا نتساءل دائما: هل هذا التطرف هو الذي أدى إلى هذا النقل الممتع إلى الفرنسية
لـ»النمور الثلاثة الحزينة»؟ لنعد إلى الزواج الأقل سعادة بين المؤلف والمترجم: إن هذا الشعور الأول بالإعجاب والتعاطف الذي يوقظه النص؛ يمكنه أن يتأثر بصورة الإنسان – المؤلف، ويمكنه أن يؤدي إلى فقدان الإعجاب لدى المترجم، أو إلى موقف الارتياب، وتتدخل بالتأكيد كلُّ ردود الفعل هذه، بشكل سلبي، في عمل الترجمة. يتعلق الأمر إذن بالتَشَبُّعِ بالنص، بالغوص فيه، بمعرفة كيف نَقرأ.
قراءة النص
إن دروس الترجمة التي أقدمها هي، في المقام الأول، دروس في القراءة، بمعنى، أنها دروس تُمكِّن من تعلم كيفية رصدِ كل العناصر التي تنسج نصا معينا، من هنا يُطرح السؤال عن كيفية إعادة بناء إرسالية لم نُدرك سوى جزء واحد منها؟ أحب هنا أيضا أن أُميز في القراءة بين القراءةَ الموضوعية والقراءة الذاتية.
تقتضي القراءة الموضوعية لنص معين رصدَ جميع مداخله ومخارجه، الوقوفَ على أسباب الآثار التي يُحدِثها، الكشفَ عن كل الخيوط التي تُركّبه، تشريحَه، وإبرازَ جميع العناصر التي تُشكله، والتي لن نذكر منها سوى القليل: الخيط الناظم للمنطق النصي، الحقول الدلالية المحدِدة للمظهر والسِّجل النصيين، الشكل الفيزيائي المحدِّد للأسلوب والمظهر، أي: الشكل الموسيقي، الصوتي، التركيبي والدلالي. يجب على كل مترجم جيد أن يبدأ عمله بتحليل نصي عميق. أما في ما يتعلق بالقراءة الذاتية – الواسعة الانتشار بالتأكيد، والمنتظَرة من كل قراءة – فإنها تُعَدُّ واحدةً من الخطايا الرئيسية السبع للترجمة. تُعتبر كل قراءةٍ عاديةٍ [بسيطةٍ] إدراكا للمعنى الذاتي. إنه منذ اللحظة التي يَبْرَحُ فيها الكِتابُ طاولةَ المؤلف، لن يعود مِلكا له، ويُصبح مُتغيِّرَ الشكلِ. إننا نُقدم جميعا صورة مخالفة لمدام بوڨاري، وهو السبب الذي لن تروقنا معه الصورة الفِيلْمِيَّةُ التي فُرِضَتْ علينا نتيجة قراءة المخرج الذاتية لهذا الأثر.
تُعَدُّ كل قراءةٍ قراءةً تفاعلية. إن هذه التفاعلية التي طُوِّرَتْ ووُظِّفَتْ، بشكل كبير في أيامنا هذه في المجال الإلكتروني، ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة دائما، وإنما بشكل مُحْتَشِمٍ. يَمزج القارئ بالتأكيد شخصيته بالنظرة التي اقْتُرِحَتْ عليه. أن تقرأ يعني أيضا مواصلةَ الكتابة التي أنجزها المؤلف، إتمامَها، تشذيبَها بمعنى أو بآخر. إن القارئ كاتبٌ مساعد. يجب على المترجم أن يحذر هذه الوظيفة الاختزالية.
من الوجهة المثالية، إن ما يجب أن يقوم به المترجم هو إعادةُ بنائه جميعَ القراءات الممكنة، لا قراءَته الخاصة فقط. بمعنى آخر، يجب عليه أن يعود إلى المعاني المتعددة للنص المَصدر. كل نص عظيم للمؤلف هو نصٌّ متعدد المعنى، دون أن يكون كاتبه على علم بذلك في الغالب. أود أن أؤكد، وبنوع من الفرح الماكر، أن المؤلف يجهل في الغالب حمولة ما يقوله.. إنه يُتقن بالطبع ما يكتبه، يُعيد في مهنته عمله مئة مرة، يعرف أين يسير ويعرف ما يود التعبير عنه. ويعني هذا أن المؤلِّف هو «الذي يُكْتَبُ» أكثر من كونه الذي يَكْتُبُ، حيث تتسلل عناصرُ أخرى إلى كتابته دون وعي منه: التناص، اللاوعي، جوهر نفسي بأكمله ينفلت منه ويتسرب إلى كتابته مع ذلك. والحالة هذه، فإن المترجم يمكنه أن يكون مُدْرِكاً كل ما يتسلل إلى كتابة المؤلِّف دون عِلمه. إنها هنا قراءة خاصة لا تتطابق بالضرورة مع القراءة التي يقترحها المؤلف. يقودنا هذا إلى إمكانية اللقاء الضروري بين المؤلف والمترجم أو عدمه. إن مساعدة المؤلِّف بإمكانها أن تكون نفيسة، حين يتعلق الأمر ببعض القضايا الدقيقة والعملية، هو وحده الذي بمقدوره الإجابة عنها، مثل بعض الإحالات التاريخية أو الطوبوغرافية، أو بعض التلميحات التي يملك وحده مفتاحها أو بعض الإيحاءات الشخصية، أو غير ذلك. ومع ذلك، يبدو لي أن الحوار بين المؤلف والمترجم هو قطعا حوار غير مناسب تماما، بل خطير، حين يشرع المؤلف في تقديم حُكْمٍ على الترجمة. هنا، يمكن لتدخله أن يكون سلبيا.
ويعود السبب البدَهِيُّ لذلك إلى كون المؤلف لا يَحْذِقُ، في أغلب الحالات، لسان الوصول إلى درجة قدرته على تقويم جودة النص المُتَرْجَمِ. ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون تَدَخُّلُ القارئ مجحفا لأن قراءته الخاصة قد تُصبح اختزالية، ويحدث ذلك عندما يؤكِّد للمترجم أن هذا أو ذاك هو ما كان يَوَدُّ قوله بالضبط، وأنه يجب عدم فهمه إلا في هذا المعنى الوحيد.
والحال أن المترجم يمكنه بالفعل أن يكتشف في النص أشياء أخرى أثرى من تلك التي وضعها المؤلف بوعي منه، كما يمكنه أن يكشف بعض الأفكار المهيمنة التي يجهلها المؤلف نفسه، وأن يعثر على شريان مهم لتوظيفه، وتوجيه ترجمته استنادا إلى هذه العناصر التي رصدها بنفسه.
أصل الآن إلى خلاصتي: الترجمةُ هي، أولا وقبل كل شيء، قراءةٌ.
يعني ذلك أن تقرأ بشكل صحيح، أن تقرأ بعين المُفَسر المُحَنَّكِ، بأذن المؤلِّف الموسيقي، بحساسية الفنان المُرْهَفَةِ حيث الحواس الخمس متيقظةٌ. ويعني أيضا أن تقرأ بالعين المتعددة للذبابة، عينٍ تلتقط كل القراءات الممكنة بِهَمِّ الأمانة للمعنى المتعدد، المعنى الممكن الوحيد.
يجب على المترجم الجيد أن يتقمص موقف المتزحلق الذي يقتفي آثار المدرب -المؤلِف، بانحرافه عنه بأقلَّ ما يمكن، وبتعلقه بحركات ودينامية وإيقاع الجسد الذي يتبعه عن قرب؛ لأن المؤلف إذا كان يمتلك العبقرية، فإن المترجم لا يمكنه أن يكتفي بامتلاكه الموهبة وحسب. يتوفر كل نص كبير على نَفَسٍ يَحْمِلُهُ ويأخذه، على انسجام نَغَمِيٍّ ومُنْعِشٍ يضفي على المكتوب وحدته ويجعلنا ندرك أصله في كليته، بل وفي كل قسم على حدة. إن المترجم الذي كان سيقوم فقط بتصفيف أحجار الفسيفساء بعناية جنبا إلى جنب، دون إتقان العملية برمتها، أو الذي كان سيعزف بشكل صحيح كل نوتة موسيقية على حدة، دون أن يأخذ بعين الاعتبار اللَّحن في شموليته. إنه لن يكون، باختصار، سوى مُنَفِّذٍ صغير ومُدَقِّقٍ عاجزٍ عن إدراك غزارة مُؤَلِّفِهِ، وعن إدراكه في شموليته، إن هذا المترجم لن يكون أمامه إلا البحث عن مهنة أخرى..
القدس العربي




