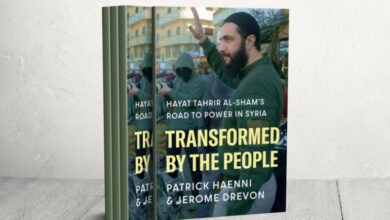مقهى كربيس: رحلة طبيب دمشقي إلى الجزيرة السورية في الأربعينيات/ محمد تركي الربيعو
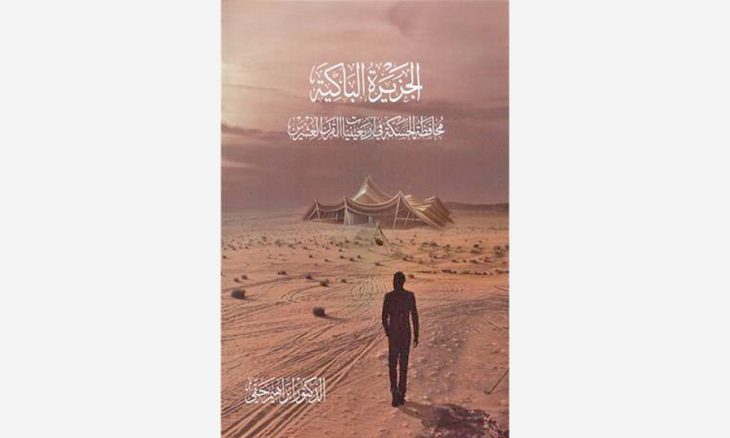
قبل سنوات قليلة من الآن، عمل الطبيب الدمشقي إبراهيم حقي (مواليد 1920) على نشر ما في جعبته من أوراق ويوميات كتبها على مدار ثمانين سنة من حياته، بدءا بالمرحلة الثانوية في مكتب عنبر، ولاحقا خوضه مسار دراسة الطب وترؤس عدد من المؤسسات الصحية، وآخرها مشفى دار الشفاء في دمشق، والتي تعد واحدة من أهم المشافي الخاصة في حياة المدينة. وقد صدرت هذه الأوراق في عدد من الأعمال، أهمها ما صدر في أربعة مجلدات تقريبا. تناول في الأولين حياة دمشق على صعيد التطور الحضري واللباس والطعام وثقافتها، أما الآخرين فقد صدرا تحت عنوان «سيرة طبيب دمشقي في القرن العشرين» ورصد من خلاله حياته المهنية وواقع القطاع الصحي وعالم الممرضين، الذي خصّص له فصولا عديدة.
وبموازاة هذه الإصدارات، كان قد جمع بعض اليوميات التي دوّنها في عام 1944 عن منطقة الجزيرة السورية، بعد زيارته لها في مهمة طبية. ففي هذه الفترة، كان التيفوس قد انتشر في البلاد، ولذلك قرّر الفرنسيون بالتعاون مع الحكومة السورية إرسال حملات إلى المناطق النائية للتطعيم، وقد اختار يومها حقي، الذي كان يدرس في السنة الخامسة تقريبا في كلية الطب، السفر إلى الجزيرة السورية للقيام بهذه المهمة. ولأنّ حقي كان مولعا بكتابة يومياته منذ الفترة الثانوية، فإنه في موازاة سفره، كان يقوم بتدوين تفاصيل هذه الرحلة، وانطباعاته عن المدن والبلدات التي زارها. وقد حاول في عام 1946 نشر هذه الملاحظات في كتاب، لكن ظروفه المادية يومها لم تكن تسمح. وقد بقيت هذه المذكرات مدفونة بين أضابير مرضاه، ليعود بعد الأحداث في سوريا عام 2011 ويقرر نشر هذه اليوميات.
ومما يذكره في سيرته، أنّ ما دفعه لذلك هو رؤيته بعد أحداث عام 2011 مشهد «انقسام أهالي محافظتي الرقة والحسكة وفقا لقومياتهم وأعراقهم.. ما ذكرني بجولة قمت بها في منتصف العقد الرابع من القرن العشرين». وبالتالي نرى هنا أنّ مشروع كتابة الذاكرة ونشر اليوميات، ليس مشروعاً مخططاً له مسبقا، بل مسألة راهنية جدا، وبالتالي فإنّ الذاكرة ومأسستها هي صناعة وعمل يومي. وهذا ما يُحسب في الآونة الأخيرة لدار الفكر في دمشق، التي أخذت على عاتقها بعيد الحرب نشر عدد من السير الذاتية عن المدينة وسوريا عموما (بما فيها نشر كل نتاج إبراهيم حقي الغزير).
ما تجب الإشارة إليه هنا، أنّ حقي لا يكتب عما شاهده قبل عقود، وإنّما يعيد في كتابه نشر ما دوّنه في يومياته ورسائله. ولعلّ ما يقطع الشك باليقين هنا، ما سنراه في كتاب آخر صدر قبل أيام بعنوان «رحلة الشتاء والصيف» ودوّن فيه الرسائل التي كان يرسلها لصديق الدراسة والمهنة الطبيب راتب كحالة (مؤلف كتب في الطب) حول رحلته الصيفية إلى الجزيرة 1944 ولاحقا رحلته الشتوية إلى محافظة دير الزور. ولذلك فإنّ ما يميز هذه الرحلة أن ما سنقرأه يمثل شهادة دوّنت آنذاك من قبل شاب دمشقي، عاش في حي القنوات القديم، وكان يزور المنطقة لأول مرة.
ستكون أولى الرحلات خلال الصيف، وفي الطريق إلى الجزيرة سيروي لنا مشاق السفر بسبب الطرق الترابية، وأول ما سيلفت نظره واقع مدينة الرقة آنذاك، إذ يقول: بدت «بلدة حقيرة ليس فيها ما يدلّ على عزها الغابر إلا اسمها» وعلى الرغم من الوصف القاسي للمدينة، لكن ما يذكره هذه الطبيب يتطابق مع ما كتبه بعض أبناء المدينة في السنوات الأخيرة عن بدايات تشكّلها الحديث. فالمدينة الحديثة، كما يلاحظ مثلا الباحث السوري معبد الحسون (حفيد مؤسس المدينة الجديدة) أعيد تشكيلها في بداية القرن العشرين حول إحدى الزوايا الدينية. وبعد مكوثه لاحقا في دير الزور والتي سيروي بعض تفاصيلها، سيكمل طريقه إلى الحسكة. وأول ما سيكتبه عند وصوله «يبدو لعين الداخل إلى الحسكة من مسافة بضع كيلومترات بناءان ضخمان.. ويظن أنه سيلقي مدينة كمدينة دمشق» لكنه لا يلبث أن يكتشف أنّ البنائين هما دار الحكومة ودار المحافظ، وما سواهما بيوت متواضعة مبنية من اللبن أو الحجر «الغشيم».
وستبدو له مساحة المدينة مشابهة لمدينة دوما في ريف دمشق، لكن عدد سكانها أقل، مبنية على ضفة الخابور اليسرى، وشوارعها متقطعة كلها وعريضة نسبيا وليس فيها حارات، ذلك لأنها حديثة البناء. وفي الليل كانت تنار بـ»اللوكسات» التي توضع في الساحات العامة. وعلى صعيد الخدمات، لا تتوفر الكهرباء في جميع منازلها. كما أنّ المياه لم تكن تخضع للتعقيم وتُنقل من الخابور عبر سقاة مختصين بهذه المهنة. كما ستبدو آنذاك عبارة عن خليط من اللغات العربية والكردية والسريانية والعربية، التي لم يكن يفهمها أيضا، فاللغة العامية (البدوية) بدت له آنذاك صعبة على الفهم، كما ستبدو له بعض التصرفات التي سيراها صعبة على الفهم أيضاً، ومنها مثلا كرم بعض شيوخ القبائل، إذ سيسجل حقي مثلا أن هذا الكرم لم يكن ناجما عن مواقف أخلاقية بالضرورة، بل لحسابات سياسية ورغبة من بعضهم في الحصول على مناصب حكومية مثل منصب المختار. صحيح أنّ الكرم ليس في الأساس موقفا فطريا كما وجد مارسيل موس، بل الهبة (الكرم) وفق تعبير موس هي عبارة عن «سيستم اجتماعي» يتيح للجماعات تبادل الأدوار والتأقلم مع واقع غير مستقر، لكن ربما هذا «السيستم» بدا غريبا على ثقافة ابن مدينة دمشق.
ويعود حقي، المولع بأسواق دمشق وحكاياها، ليؤكد أنّ البدو ممن وجدهم كسإلى، يتسامرون طوال اليوم ويتناقلون سوالف عن الحروب و»الكونات» ويرفضون العيش في البيوت، ويفضلون عوضا عنها الخيم. مع ذلك نراه يعود في إحدى رسائله ليعبّر عن موقف آخر بدا رومانسيا، عندما يقارن بين البدو وأهالي المدن، فأهالي المدن كما يقول «أصبحوا أكثر عبودية.. عبيد أصنام، وعبيد عادات، وعبيد تقاليد.. أنت تأخذ على البدو الرحل أنهم في حرب مستمرة، أما ترى الحروب المستمرة في كل بلد». كما سيزور خلال مكوثه في الحسكة قرى عديدة من أجل تطعيم الأطفال، مثل تل صخر وأم قيصر وناحية الشدادي (الشدادة، كما يكتبها) وكان يشغل مدير ناحيتها آنذاك الشيخ حامد العلي الأسعد (أحد شيوخ قبيلة الجبور) الذي استضافه في منزله وطلب منه تطعيم ابنته (سورية) وقرية جرمز «القرية الوحيدة التي رأيت فيها جامعا».
مقهى كربيس في القامشلي
سيكمل حقي طريقه لاحقا إلى القامشلي ورأس العين، وهنا سيختلف المشهد كثيرا عن واقع الحسكة. إذ سيكتب يومها عند وصوله «أنني وجدت أجمل مدينة في الجزيرة من حيث التنظيم، فكلها شوارع متقاطعة فيها أسواق لا بأس بها ومخازن لحاجيات الإنسان كافة، وأبنيتها من اللبن لكنها منتظمة نوعا ما، وفيها كنائس مفتخرة وجامع وفيها سوق هال ممتاز جدا، وشوارعها منارة بالكهرباء، كما أنّ بعض البيوت مزودة بأنابيب منتظمة». ولن يقف مديحه للمدينة عند هذا الحد، بل سيكتب أنّ «أشهر ما فيها مقهى كربيس المشهور، الذي ليس له مثيل في دمشق نفسها.. فهو عبارة عن مقهى واسع فيه أشجار منوعة وحدائق جميلة منسقة، ومطعم يقدم أفخر أنواع الطعام، يقصده الأكابر من أنحاء الجزيرة كافة لتمضية يوم أو ليلة فيه».
ويبدو عند المقارنة بين الحسكة والقامشلي الفرق واضحا، كما يقول حقي، خلال منتصف الأربعينيات. ولعل هذا الرأي لا ينطبق فقط على مشاهدات المؤلف، بل نرى زائرا دمشقيا آخر، وهو التاجر بدر الدين الشلاح، يذكر في مذكراته مقارنة شبيهة عن واقع المدينتين، إذ يقارن مثلا صورة القامشلي الغنية بأسواقها في الخمسينيات بواقع الحسكة التي بدت له أشبه بقرية، لكن من الأمور الطريفة التي ستبقى تشغل بال حقي، هي لهجة أهل القامشلي العربية (البدو) أو لهجة أخرى سمعها كما يقول من خلال إحدى الأغاني، ورغم أنه لم يفهمها إلا أنه تمكن من تدوين كلماتها، وفي الأغلب هناك من ساعده في التقاطها وتقول «في رأس هاك الجبل دومي انكسر عوده.. دلالي دلالي.. وجيب دواية وقلم واكتب على خدوده.. دلالة دلالة». ويكمل «قلت وما معنى هذا الكلام.. هذا عربي؟» والكلمات تعود للتراث الموسيقي المردلي (نسبة لأهالي مردين) الذين سكنوا مدينة القامشلي بعد تأسيسها في النصف الثالث من القرن العشرين. وقد يبدو حقي محقا في استغرابه من أسلوب لفظها، فهي وإن كانت لغة عربية، لكن تحتفظ برنة وأسلوب خاص في النطق، ولذلك تبدو غريبة بعض الشي على القادمين من الخارج، وحتى لدى باقي أبناء الجزيرة، حتى سنوات قليلة ماضية.
لاحقا سيكمل طريقه العلاجي نحو رأس العين، وهنا سيدون حقي أنه ليس في هذه المدينة ما يستحق الذكر سوى مناظرها الطبيعية، إذ بدت له بلدة صغيرة، لا يزيد عدد سكانها آنذاك عن الألفين، لكنهم إجمالا مهذبون ويتألفون من أقوام نازحة سواء في ذلك العرب، أم الأكراد أم الشيشان، أم الآشوريين. ويؤلف الحلبيون كما يقول قسما كبيرا من العرب، ولذلك كان يسمع أحيانا أصوات الحلبيين وهم يتكلمون بلهجتهم من المقهى الكائن أمام داره. وأكثر ما ألمه كما يذكر هو مشهد بيت الشعر المنصوب على بعد مئتي متر من المدينة يسكنه رئيس قبيلة البشوات (وهم أكراد) وشيخها آنذاك خليل بك وابنه محمد علي بك، الذي درس في مدرسة اللاييك الفرنسية في دمشق، وكان يتقن الفرنسية، مع ذلك آثر الشيخ وابنه استقبال ضيوفهم فيها بدلا من البيوت. بينما بدا الشيشان أكثر اهتماما ببناء البيوت والسكن فيها والنظافة، خلافا للأكراد والبدو، كما يثني على تهذيبهم، لكنهم كانوا متعصبين كما يقول. وفي مقابل هذه الصورة يصوّر الآشوريين في ريف الحسكة (تل رمان وتل هرمز) بملابس بالية وهيئات رثة وأحوال تعيسة.
بعد هذه الرحلة بعام، سيعود حقي ليكتب رسائل من دير الزور إلى صديقه كحالة يحدثه فيها عن رحلته الشتوية إلى ريف المدينة في عام 1945. ويبدو أنّ الرسائل كانت تمثّل آنذاك وسيلة للتواصل من ناحية، وأدبا للحديث عن التغيرات الاجتماعية والسياسية المحيطة بكاتبها. وهذا ما وجدناه في دمشق مع فخري البارودي والشلاح، وهذه المرة مع حقي، الذي يخصصها للحديث عن مدينة البوكمال وقراها. وفي سياق وصفه لها «بيوتها من اللبن ومساحتها أكبر من مساحة مضايا بقليل، طرقاتها كلها متقاطعة ولا بأس بعرضها، لكن ليس فيها أي شارع معبّد فكلها طين وتراب، وعدد سكان البلدة أربعة آلاف شخص، وفيها سوق لا بأس به بالنسبة لها، وفيها مدرسة ابتدائية ومدرسة أهلية صغيرة وفيها الفندق الذي ننزل فيه (لا أراك الله مكروها) والقائم مقام فيها اسمه أمين العليوي، وهو ديري الأصل».
كما يذكر أنّهم في زياراتهم للكثير من القرى وعند وصولهم، كان يتجمع أمامهم مسلحو القرية ويشهرون أسلحتهم في وجوههم، ظنا منهم أنّ سيارتهم تحمل رجالا من قبيلة شمر، ويبدو أنّ السوالف عن غزوات قبيلة شمر كانت محل نقاش يومي في المنطقة. كما يؤكد أنّ أهالي البوكمال وقراها كان يعبرون يوميا نحو الحدود العراقية دون وجود حواجز أو مخافر بلا رقيب أو حسيب.
كاتب سوري
القدس العربي