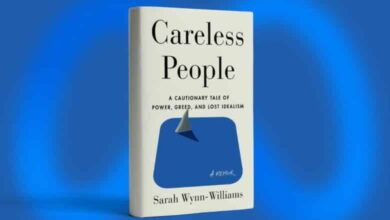فاطمة المحسن في “الرحلة الناقصة” إلى مدينة أين/ بشير البكر

تدور الكاتبة العراقية بين لندن وبغداد وبيروت.. لأن “المدن كلها قبض ريح”
لندن، بغداد، بيروت، درب السعادة الذي يقود الكاتبة العراقية فاطمة المحسن في “الرحلة الناقصة” للبحث عن مدينة أين، التي سافر إليها الشاعر الراحل سركون بولص، في رحلة تشبه قصيدة شاعر الإسكندرية قسطنطين كفافي “المدينة”. وتقف بيروت مثل فاصلة معترضة بين مدينتين، الأولى هي الوطن الأصلي العراق، والثانية هي الوطن البديل بريطانيا. إلا أن المدينة تبقى انتظاراً مجهولاً يلوح ثم يختفي، وتظل بيروت في مصاف المدن البحرية في انتظار ورحيل، تراها من صوب البحر عند هبوط الطائرة وفي صعودها.
تدور الكاتبة بين المدن الثلاث. ولأن “المدن كلها قبض ريح”، فإن المرء يعبرها في تجوال سريع مثل ساعي بريد أضاع العناوين، وفقد ذاكرته. في بغداد كل شيء يمضي مسرعاً، لا ثبات في الأماكن. مدينة تعمل في الصمت والضجيج، وتحفر أنفاقها “في وعورة أجسادنا، وفي وقوفنا بين الخطوط المتقاطعة لمتاهاتها”، بينما بيروت صغيرة، ويبقى اندماج الناس فيها أقل صعوبة من بغداد والقاهرة، في مخيالها دائما باريس التي استبطنت أساليب حياتها وحوّرتها ودورتها، كي تكونها بين بلدان الشرق العربي. وتحتل لندن في طريق السفر المطاف الأخير في رحلة ستكتمل أو تنقص يوماً وسنة وشهراً. وفي كل ذلك تبقى مغادرة الأماكن الأولى اقتلاعاً لا يدرك فداحته حتى الذين يعيشون تفاصيله.
في حديقة البيت اللندني يحضر الأصدقاء القريبون والبعيدون بقيادة فالح عبد الجبار، الزوج الذي كان يشعل النار في برد المدينة. ويتحلق حوله أصدقاء في أغلبهم من مرحلة جريدة “طريق الشعب” صحيفة الحزب الشيوعي العراقي، فتحضر سير رفاق وأصدقاء في دفتر المأساة التي واجهها الحزب ومثقفوه، خصوصاً أولئك الذين ظلوا في بغداد، ودفعوا الثمن مثل الشاعر يوسف الصايغ الذي “يكتسي لديه النضال طابعاً كرنفالياً”، احتفاء الشهادة والشهداء أحد مظاهره. وقبل أن تغادر الكاتبة العراق هرباً من القمع، تعرج عليه متنكرة لتنصحه بضرورة مغادرة البلد، لأنه لا يحتمل اختباراً كالذي مر به في انقلاب البعث الأول العام 1963، لكنه كان قد تلقى أمراً حزبياً بالبقاء، لأن قيادة الحزب تريد أن تحوله “إلى كبش فداء”، هذا الحزب الذي نزف خيرة شبابه “وبقي القادة من دون نقصان”.

هؤلاء القادة كانوا يعتبرون الحزب قطارهم الخاص، ويطلبون من كل الرفاق النقديين النزول منه، وهذا سبب ترك الكاتبة للحزب العام 1980. وبالفعل فإن هذا الشاعر يوسف الصائغ، واجه مصيراً مرعباً، ومن شدة فزعه كتب كلمة في مديح صدام حسين. وكانت ظاهرة الانهيارات تحت التعذيب في السجون، وهروب اليساريين الجماعي خارج العراق، وبينهم المثقفون، التوقيت المناسب للإعلان عن الحرب مع إيران. وتتوقف الكاتبة مطولاً عند الذين هربوا قبل أن تبلعهم السجون. وغالبية هؤلاء كانوا يشكلون حلقة الأصدقاء في لندن، الكاتب زهير الجزائري، الشعراء صادق الصائغ، فوزي كريم، شريف الربيعي. ولا تنقطع المودات بين هؤلاء الذين تفرقهم الأماكن والمسافات، ويجمعهم التعويض عن العائلة والضياع في المدن والبحث عن زورق يؤجل الغرق في بحر المهجر المترامي. وتشخص الحالة الثقافية لهؤلاء الذين “ربما بسبب حياة قربتنا من فردانية كنا نفتقدها في العراق، بتنا نعجز عن تشكيل مجموعات ثقافية”. وهي تفحص مواقف المثقفين العراقيين في حوارات عن المنفى، وما يؤمن به صلاح نيازي وسميرة ونجيب المانع ثم فوزي كريم، فهم يرون أن الثقافة تنقسم بين ضفتين، المعارف العربية والحديثة على وجه الخصوص، وهي لا تساوي الكثير، مقابل الثقافة البريطانية او الغربية العظيمة. ويبرز هنا نجيب المانع كمثقف ومترجم (فيتزجيرالد: “غاسبي العظيم”) وباحث وكاتب في الشأن الموسيقي وتأثيره في هؤلاء، وكأحد أهم الوجوه الثقافية العراقية في الخمسينيات، فإن ما وصل إليه من مكانة لم تكن ترضي طموحه، ومات وحيداً فوق كرسيه، ولم يتم اكتشاف أمره إلا بعد أيام. ويقابل هؤلاء على الضفة الأخرى نموذج آخر مثل الشاعر والمترجم فاضل عباس هادي الذي كان يكتب بالإنكليزية قبل خروجه من العراق. لكنه يحمل موقفاً يصل حد العداء للثقافة البريطانية.
ولا تشذ فاطمة المحسن عن بقية الكتاب والمثقفين العراقيين الذين سجلوا شهادات عن مرحلة التأسيس في الثقافة العراقية، وتبقى الستينيات هي المرحلة الأكثر ألقاً، وفيها ظهر جيل شعري متميز خصص له الشاعر عبد القادر الجنابي كتاباً أطلق عليه “انفرادات الشعر الستيني”، ومن هؤلاء الجنابي نفسه، مؤيد الراوي، فاضل عزاوي، فوزي كريم، وسركون بولص. وكرس كتاب الجنابي الشعر كفن يتقدم على الفنون كلها، والشاعر باعتباره البطل الثقافي. وسجلت الكاتبة محطات ووقائع حول تفكير هذا الجيل، وتعدد وجهات النظر حوله، وفتحت صفحات من السجلات الشخصية بين هذه المجموعات التي توزعت بين لندن وباريس وبرلين والولايات المتحدة كما هو حال سركون بولص الذي رحل العام 2007، وكان قد تردد على أوروبا قبل ذلك. وتخوض الكاتبة في تفاصيل مناوشات كانت تقع بين هؤلاء الذين يتحلى كل منهم باعتزاز وتعظيم الذات. وحين تتوغل في عوالم الكتّاب العراقيين في الخارج تتوقف عند تجارب مهمة. الأولى تجربة سركون بولص الذي تعده من أبرز الشعراء العرب، ومن بين أفضل مترجمي الشعر، لكنه في كل مرة يخوض نهراً، لا يصل إلى مكان. والثانية، تلك التي تخص الشاعر خالد المعالي، الذي أسس واحدة من أهم دور النشر العربية “الجمل”. والثالثة تجربة الشاعر والروائي صاموئيل شمعون الذي كتب رواية جميلة عن تجربة التشرد في باريس “عراقي في باريس”، وأسس في لندن مع زوجته ماغي أوبانك مجلة “بانيبال” التي تخصصت بترجمة الأدب العربي إلى الإنكليزية، فأصبح من بين محركي النشر، و”جسراً بين الثقافتين العربية والإنكليزية”. ويحضر شريك حياتها الكاتب والباحث فالح عبد الجبار الذي تهديه الكتاب وتسميه “رفيق الرحلة” التي نقطة البدء فيها التاريخ المشترك معه برفقة أصدقاء آخرين مثل زهير الجزائري، الودود والاجتماعي الذي يوحي وجهه بالطيبة. وتحضر ذاكرة بيروت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ويشكل مقهى “أم نبيل” في “جمهورية الفاكهاني” ملتقى دائماً للشعراء والمسرحيين والفنانين العراقيين، هاشم شفيق، حيدر صالح، شاكر سلامة. وتصبح بيروت في عين الكاتبة النافذة التي أشرف منها العراقيون على عالم مفتوح من الصحف والأفلام الحديثة والكتب التي لا تتوافر ببغداد، والاختلاط بالعرب والأجانب.
يحمل الكتاب مراجعة نقدية للحزب الشيوعي العراقي الذي انتمت له المحسن وغالبية الأصدقاء الذين تتناول سيرهم في الكتاب، وكذلك الأمر لتجربة العمل في صحيفة الحزب “طريق الشعب” التي تصفها بـ”المعارضة والمؤيدة”، والتي جمعت شغيلة الفكر أو بروليتاريا الثقافة.. وتوثق مرحلة السجن الذي هو “انقطاع وقطع للحاضر واليومي والمعيشي”، وتسجل هذه التجربة على سبيل الخلاص منها، هذا ما نصحها به الأصدقاء، وعلى سبيل المراجعة تعتبرها “حماقة ارتكبتها بحق نفسي”. وتتوقف عند المذابح التي تعرض لها الحزب في العامين 1978 و1979، والتي لم يتضامن مع الشيوعيين فيها سوى منظمة التحرير الفلسطينية، وصمت الاتحاد السوفياتي الحليف والنظام البيروقراطي الغارق في الفساد.
وتروي رحلة الهرب على ظهر بغل إلى كردستان العراق، وبعدها الى مهاباد، حيث يساعد الحزب الديموقراطي الكردي الإيراني، الذي يتزعمه عبد الرحمن قاسملو، للوصول إلى طهران، التي بدأ فيها النظام الديني مطاردة الشيوعيين، فتلجأ إلى سفارة فلسطين فيواجههم السفير هاني الحسن بأنه لا يتفق مع الشيوعيين، لكنه تلقى أوامر من ياسر عرفات للاهتمام بهم.
ومن بيروت إلى بودابست، وبعد دراسة جامعية استمرت خمس سنوات، وكانت ثمرتها دكتوراة وأطروحة “التجديد في الشعر العراقي/ سعدي يوسف نموذجاً”، كانت دمشق “أجمل هدية تلقيتها في حياتي”، التي وجدت فيها “حلم العودة الوحيد إلى الوطن”. وفي مجلة “الحرية” التي تصدرها الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، تبدأ مرحلة جديدة، تلتقي فيها مع العديد من الأصدقاء القدامى وآخرين جدداً، ومنهم سعد الله ونوس الذي تحول منزله إلى ملتقى، لكن التجربة عرفت خاتمتها مع اجتياح العراق للكويت في العام 1990، وهنا جاءت فرصة الرحيل إلى لندن، تاركة دمشق الكريمة بأهلها ومناخها وأماكنها الأليفة ومجتمعها البسيط المتحضر، والتي بدت “وكأنها بغداد التي في خاطرنا”. وتشكلت مظلة حماية من المخابرات في هذا البلد بفضل العمل في الصحافة الفلسطينية، والعلاقات التي بنتها منظمة الحزب الشيوعي العراقي مع السلطة السورية، وعلاقات سكرتير الحزب السابق فخري كريم. وفي حين تعيب على نظام صدام حسين أنه كان يستقطب المثقفين العرب، تعتبر ان استقبال دمشق المنفيين من الجنسيات كلها “خطة من حافظ الأسد لا تخلو من ذكاء”. وتتوصل الكاتبة إلى استنتاج غريب وهو “أن معظم المثقفين في سورية هم من الطائفة العلوية”، ويفسر لها سعد الله ونوس “ظاهرة المثقف العلوي” بأن الطبقات الغنية المتنفذة في سوريا لم تُقِم وزناً للعلويين… والعوائل التجارية الكبيرة تركت لهم الجيش والتعليم”.
لندن مدينة ثقافية، هكذا ترى الكاتبة، تشعرك بالغياب، بزمنها الراكز المتطامن مثل صوت قطاراتها وضجيج محطاته. تستقبل الأعراق بنوع من الدهشة والإعجاب. لكن الجميع هنا آخرون، ويتبدى الوجه الثاني للإنكليز كلما اقتربت من حي شعبي أبيض، وجه عنصري متعالٍ، لكنها تدين لبريطانيا بحب يشبه حب الوطن، وتكتشف مقدار الظلم للإنكليز حين تصاب بالسرطان، “فهم أنبل الشعوب لمن يحتاج مساعدتهم مهما كان جنسه ولونه”.
الصدمة الكبرى تحصل عندما تعود فاطمة المحسن وفالح عبد الجبار، أول مرة إلى بغداد بعد إسقاط القوات الأميركية لنظام صدام حسين العام 2003، سائق التاكسي الذي أقلهم من المطار يسألهم من أي بلد أنتم، وهو يستمع إليهما يتحدثان اللهجة العراقية. صديقتهم مها البياتي تحجبت، وبادرتهم “تغير العراق لا مكان لكم هنا، ستتعبون”. وتقول جئنا هنا كي نرى العراق ينتظرنا كما تركناه.. لم ندرك مفارقة أن الوطن لم تكن به حاجة إلى عودتنا، “تعودنا على المنفى، وتعودنا على انتظار الوطن”. وهكذا تكتشف انها فقدت العراق بعد عودتها إليه، وستفقد بعده المدينة كلها على حد قصيدة كفافي “المدينة”، ومع أن المهاجر يتعود مع مرور الوقت رمي متاعه على أرصفة المدن من دون شعور بالخسارة، فإنه لا يصدق نفسه حين يحاول أن يكون من دون وطنه الأول.
وتأتي فترة مرض السرطان والعلاج في لندن ورحيل فالح عبد الجبار الذي خلف فراغاً كبيراً في حياة المحسن، ومحطات أخرى في الكتاب، الذي يقف أمام قدر لا يستهان به من الحكايات التي تخص فئة من الكتّاب العراقيين، ولا تهم القارئ البعيد، من أجواء الخصومات والمشاحنات بين بعض أطرافها، وذلك بالقدر الذي تحاول الكاتبة أن تأخذ من تحليل بنية بعض الشخصيات مفتاحاً لدراسة نتاجها، ومثال ذلك الشاعر سعدي يوسف الذي خصته بهجاء بسبب تقلباته وعدوانيته المفرطة في عقديه الأخيرين، والتي طاولت شرائح واسعة من الكتاب والمثقفين من عراقيين وغير عراقيين، وإن كانت النسبة الأكبر التي صب شتائمه عليها من العراقيين، بلا تمييز بين الأحياء والموتى.
المدن