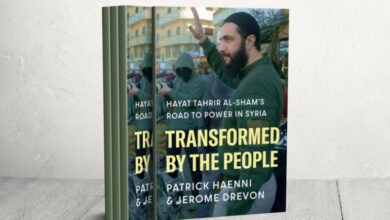“سكة الترامواي”: في اقتفاء طريق الحداثة بدمشق/ عمر كوش

يسعى سامي مروان مبيّض، في كتابه “سكّة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق” (رياض نجيب الريّس، بيروت، 2022)، إلى اقتفاء طريق الحداثة في مدينة دمشق، ابتداء من لحظة تدشين سكة الترامواي فيها، إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني في 17 فبراير/ شباط 1907، بالتزامن مع إنارتها بالكهرباء (نور الكوران) في العام نفسه، والنهضة الطبية التي عرفتها المدينة في نهايات القرن التاسع عشر، ثم تسارعت مع مطلع القرن العشرين، وذلك كي يتلمس ما فعلته رياح التغيير في هذه المدينة بشكل خاص، والمجتمع السوري بشكل عام، من خلال تسجيل محطات من دخول مظاهر الحداثة إليها وانتشارها فيها، والتي إرهاصاتها الأولى تظهر خلال مرحلة الإصلاحات، أو بالأحرى، التنظيمات العثمانية.
يعود اختيار “سكّة الترامواي”، بوصفها طريقًا لمرور الحداثة في دمشق والمجتمع السوري، إلى أنها شكلت مفتاحًا مفصليًا، أثّر بشكل بالغ في نمط حياة وأحوال سكان مدينة دمشق، حيث شكل الترامواي مكانًا يلتقي فيه بشر من شرائح اجتماعية وأعراق وديانات مختلفة، ويعكسون فيه أنماطًا من السلوك، ومستويات متباينة من الفكر والتفكير. وقد لا يدوم اللقاء طويلًا، إلا أنه يتحول إلى مختبر للحريات والمسؤولية الاجتماعية والشرط الأخلاقي للتعايش والقبول بالآخر، بوصفه مرآة لطبائع الناس ولهجاتهم، وللأفكار والمشاغل والهواجس اليومية لسكان المدينة. فضلًا عن أنه استطاع أن يربط أحياء المدينة ببعضها وبمناطق الأرياف، الأمر الذي سهل حياة الناس فيها، كما سهل عليهم نقل سلعهم وبضائعهم إلى الأسواق ومنها، وتشكلت معها شبكة للنقل العام خارج أسوار المدينة القديمة، ولعبت إلى جانب دخول الكهرباء دورًا كبيرًا في شق طرق وشوارع جديدة، وفي تشييد أحياء كاملة خارج أسوارها، أُنشئت تباعًا على طرفي سكة الترامواي، إلى جانب إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات، وخاصة “معهد الطب العثماني”، الذي أنشأ في 1903، وشكّل نواة الجامعة السورية، بعد أن أردفه العثمانيون بمعهد الحقوق، الذي أدمج مع معهد الطب في 1923 ضمن مؤسسة تعليمية واحدة أصبح اسمها الجامعة السورية.
تاريخيًا، أسهمت السكك الحديدية، التي أنشئت في مدن العالم، في تشكيل شبكات كبيرة للنقل العام، وعملت على قهر المسافات واختراق الزمن، والأهم هي أنها أحدثت طفرة في مستوى الوعي الاجتماعي لساكني المدن وما حولها، وتغيرات في مفاهيم العيش المشترك بينهم، كما أحدثت تحوّلات جذرية، طاولت أشياء كثيرة في حياة أبناء المدن، إذ لم تعود المدينة هي نفسها المدينة قبل أن تعرف هذا الناقل، كما أن سكانها باتوا يخضعون بمشيئتهم أو رغمًا عنهم، للتحول والتغير في أساليب حياتهم وطرق عيشهم.
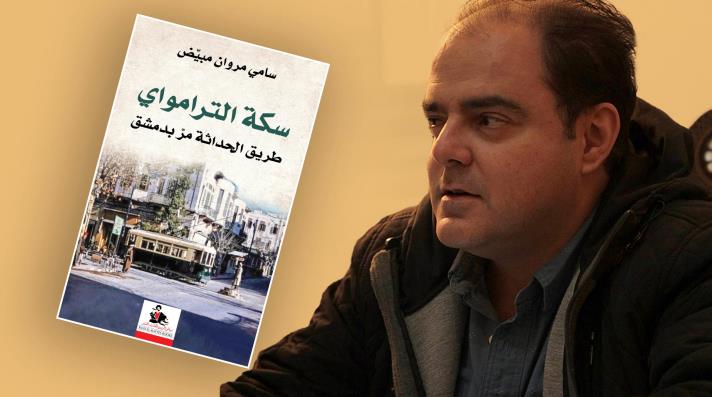
ومع تغلغل مظاهر الحداثة في مدينة دمشق، بدأت معركة التغيير على مختلف الأصعدة، والتي يتتبع المؤلف مفاعيلها على المستوى الاجتماعي، منذ نهايات القرن التاسع عشر، ووصولًا إلى منتصف القرن العشرين، وتجسدت في معارك واشتباكات “بين ثلاثة مكونات اجتماعية: الشباب المتعلّم وآباؤهم المحافظون، والرجل والمرأة، والعلمانيون ورجال الدين، وتنوّعت منصّات الصراع وكثرت أمكنته: في الأزقة والحارات، داخل المنازل، في المساجد، في حرم جامعة دمشق، على خشبات المسارح، في ملاعب كرة القدم، وداخل الأحزاب والأندية والصحف”. وعليه فإن الغاية من كتابه هي تسليط الضوء على كل هذه التجارب، بما لها وعليها، بنجاحاتها وفشلها، وخصص قسمه الأول لتناول محاولات وتجارب التغيير في السياسة والمجتمع، فيما خصص قسمه الثاني لتناول تلك التجارب في مجالات الفنون والثقافة التي وُلدت على يد أبو خليل القباني رائد المسرح السوري، ومؤسس مسرح “الميوزيكال” في العالم العربي.
وإذا كانت البداية مع سكة الترامواي، وما استتبعها من إنشاء أحياء حديثة، تحولت فيما بعد إلى معقل لشباب دمشق وصباياها مع سقوط الحكم العثماني سنة 1918، إلا أن رياح التغيير نحو الحداثة ظهرت في تجسيدات عديدة مع صدور العديد من الصحف والمجلات باللغتين التركية والعربية إبان فترة التنظيمات، ومع إنشاء المعاهد والجامعات في إسطنبول، التي خرّجت جيلًا كاملًا من السوريين، حاملين شهادات علمية في مختلف التخصصات، وظهور النشاطات والعروض الفنية مع أبي خليل القباني، وكذلك مع تأسيس أول جمعية نسائية في بيروت عام 1880، والأهم هو ظهور طبقة وسطى ناهضة في سورية. إضافة إلى الجيل الذي درس أفراده في مطلع القرن العشرين في جامعات باريس ولندن وبيروت وإسطنبول، وعادوا إلى بلدهم حاملين شهادات تخصصية في الطب والهندسة والرياضيات وسواها، ورافعين راية التحديث والتغيير، حيث وجدوا بعد عودتهم أن بعض أبنية دمشق باتت مماثلة لما شاهدوه في المهجر، إضافة إلى شبكة شوارع رئيسية تصل بينها ساحات صغيرة تليها شوارع فرعية منظمة وحدائق عامة. وبُنيت في هذه الأحياء الجديدة أبنية طابقية على الطراز الأوروبي، الأمر الذي دفع العديد من أولاد الأغنياء والميسورين إلى ترك بيوت أهلهم في دمشق القديمة ليسكنوا في هذه الشقق الجديدة.
يسعى سامي مروان مبيّض، في كتابه “سكّة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق”، إلى اقتفاء طريق الحداثة في مدينة دمشق، ابتداء من لحظة تدشين سكة الترامواي فيها، إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني في 17 فبراير/شباط 1907
يرصد مبيض ظهور جيل جديد من السوريين في الأحياء الجميلة والحديثة والمنظمة، مختلف عن الآباء والأجداد في أفكاره ولباسه وسلوكه، نظرًا لتأثره بطرق الحياة الأوروبية، حيث عاد هؤلاء “من دراستهم الجامعية في أوروبا مرتدين القبعة بدلًا من الطربوش، والبنطال بدلًا من القمباز المقصّب”، وحاملين أفكارًا أجنبية عن الدين والدولة والمجتمع، وخاضوا معركة الصراع على المجتمع، رافعين راية العلمانية في حياتهم الخاصة، وراغبين في بناء مجتمع علماني، عابر للأديان الطوائف، وجسدوا ذلك في محاولات عديدة لفصل الدين عن الدولة، بدأت حين حاول نواب في مجلس الأمة السورية في عام 1919 إسقاط البسملة من كتاب شكر وجهه المجلس للأمير فيصل بن الحسين، الذي كان يرفع شعار “الدين لله والوطن للجميع”، لكن محاولتهم فشلت أمام اعتراض المحافظين والإسلاميين، الذين كانوا يقفون بالمرصاد لكل ما يقوم به التنويريون والعلمانيون، حيث شكلوا كتلة متجانسة ومتماسكة في المؤتمر السوري العام، وفي مختلف الهيئات والتشكيلات الاجتماعية والسياسية، فيما كانت الجهة المقابلة لهم مبعثرة ومتفرقة، وتضم العديد من المهادنين للسائد في مجتمعهم. كما أن العلمانيين كانوا يشكلون قلّة في المجتمع السوري، واقتصر نشاطهم على المناداة بفصل الدين عن الدولة، وكتابة مقالات لا يقرأها إلا جمهورهم المحدود، وقد تميز بينهم عبد الرحمن الشهبندر في أطروحاته الجريئة، لذلك عمد السلفيون والمحافظون إلى اغتياله، وحاولوا الصاق الجريمة برجال الكتلة الوطنية الذين كانوا على خلاف سياسي معه.
على صعيد المرأة، برزت في البدايات أسماء نساء، مثل نازك العابد وماري عجمي وسواهما، اللتين قادتا إلى جانب أخريات معركة “تحرير المرأة من قيودها والرجل من جموده” في مجلة “العروس”، التي أسستها عجمي في عام 1910، ثم في جمعية نور الفيحاء التي أسستها العابد عام 1919. ومع نمو وتكاثر الجمعيات والنسائية برزت مطالبات النساء، خاصة حق المشاركة والتصويت في الانتخابات، الذي تمّت مناقشته ورفضه خلال جلسات المؤتمر السوري، لكن بالمقابل، حصلّن على إقرار قانون محاربة التحرش، فيما استمر الصراع داخل المجلس السوري بين المحافظين والعلمانيين، وانتهى في العهد الفيصلي لصالح المحافظين، بانتخاب رشيد رضا رئيسًا للمجلس ونائبه عبد القادر الخطيب، الأمر الذي شكل ضربة قوية للعلمانيين، أمثال سعد الله الجابري ورياض الصلح وسواهما.
حاولت فرنسا، خلال فترة الانتداب الفرنسي على سورية، تطبيق مشروع علماني فيها، حيث أصدرت قرارًا يقضي بتحويل قضايا الأحوال الشخصية كافة من المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية، باستثناء ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق، وسعت إلى إدخال مبادئ الثورة الفرنسية إلى المناهج التربوية، وشجعت السوريات على التعليم، لكنها أرادت للعلم أن يكون لصالحها، وتحت إشرافها، ومن خلال المناهج الفرنسية، وأن تصب مخرجاته لمصلحة فرنسا وليس لمصلحة الحركة الوطنية السورية. وقد أثار كل ذلك حفيظة المحافظين الذين هددوا بالعصيان المسلح في طول البلاد وعرضها، لكن ذلك لم يوقف الصراع على المجتمع بين المحافظين والعلمانيين طوال فترة الانتداب والاستقلال.
أما في الجانب الفني والثقافي، فقد برزت قضية الفنون والتمثيل بوصفها قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرر المرأة، وكلتاهما واجهت معارضة عنيفة من الشارع المحافظ وممثليه، وخاض المعركة الفنية في بداياتها أبو خليل القباني، الذي لقي دعمًا كبيرًا من طرف والي دمشق، عبد اللطيف صبحي باشا، ثم من طرف مدحت باشا. واستطاعت عروض القباني المسرحية استقطاب أبناء كبرى العائلات الدمشقية، لكنه واجه نقمة من المشايخ ورجال الدين، الذين شنوا حربًا شعواء عليه، بحجة أنه كان يلهي الناس عن عبادتهم وأعمالهم، وقاموا بتكفيره، فاضطر القباني إلى شدّ رحاله إلى حلب ومن ثم إلى مصر، لكن عطاء القباني وعائلة القباني استمر وأنتج مبدعين جددًا، حيث ظهر في الشعر نزار قباني، وظهر شقيقه الأصغر صباح في الإذاعة والتلفزيون، ومثّل كل من نزار وصباح المثال الأفضل للشباب السوري المتعدد المواهب والمنجزات، حسبما أراد لهم منير العجلاني أن يكونوا مثل ليوناردو دافنشي.
مع مجيء عهد الانفصال، بعد الإطاحة بالوحدة السورية مع مصر، أزيل الترامواي من دمشق، بحجة أن معظم الناس صاروا يملكون سيارات، ولا يركبون الترامواي، والتكلفة العالية لتشغيله وصيانته. ومع القضاء عليه فقدت المدينة شريان حياتها وشيئًا من روحها وذاكرتها، ثم جاء حزب البعث إلى الحكم، ليكمل عملية القضاء على الترامواي، وعلى نضالات وطموحات رجالات سورية الذين قادوا معركة التغيير المجتمعي، لتدخل سورية عهود الظلام والديكتاتورية المستمرة إلى يومنا هذا.
أخيرًا، لا يغفل الدور التحديثي للعثمانيين، وخاصة خلال فترة التنظيمات، وعهد عبد الحميد الثاني، والذي يعمد أغلب المؤرخين العرب إلى تغييبه. كما لا يعمد إلى تغييب دور الفرنسيين خلال فترة الانتداب، مع عدم المغالاة، وتبيان الدوافع والغايات، وعدم المبالغة كذلك في تجربة الحداثة السورية، التي عانت من حالة من التفكك والنخبوية، وبقيت محصورة ضمن محاولات فردية، ولم ترتق أبدًا إلى مصاف مشروع وطني تتبناه الدولة السورية، وبالتالي لم تتحول الحداثة إلى مشروع متكامل المعالم والأهداف والغايات، ومع ذلك فإن الكتاب يثير نوستالجيا خاصة إلى زمن كان واعدًا. كما يثير حسرة على مرحلة وجد فيها “رواد مبدعون كان في وسعهم أن يحوّلوا هذه البقعة من العالم إلى منارة حقيقية للتقدم والحضارة”، حسبما كتب أمين معلوف في تعليقه على الكتاب، حيث أن “من مآسي مشرقنا أن الحداثة الاجتماعية والفكرية، التي تبدو في يومنا هذا بعيدة المنال، بدأت تسري قبل أجيال في عروق أبنائه وبناته”، ولم يبق من مظاهرها في بلادنا سوى تجارب متفرقة، لا تلبي رغبات ذلك الجيل بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وذهبت كلها أدراج الرياح، بسبب الانقلابات العسكرية التي عصفت بسورية، وتوّجها انقلاب حافظ الأسد العسكري، الذي بنى نظامًا ديكتاتوريًا، كتم فيه على أنفاس السوريين، ثم جاء ابنه الوارث لنظام أبيه، ليقضي على حراك المجتمع السوري بأكمله، ويحوّل سورية إلى أكوام من الخراب.
ضفة ثالثة