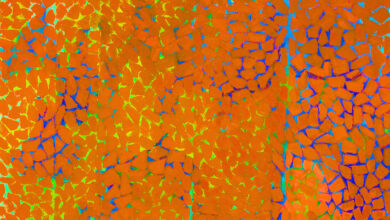مصرف «سيليكون فالي» والتاريخ الذي لا ينتهي/ صبحي حديدي

مَن اعتقد أنّ انهيار مصرف «سيليكون فالي» واقعة منطوية على المفاجأة الأدهى في العصر الراهن من أنظمة الصيرفة الرأسمالية، فقد جانب الصواب في الاعتقاد؛ على غرار ذاك الذي يظنّ أنها معزولة أو منفصلة عن سياقات أعرض، أو حتى عابرة سوف يفلح الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أو أجهزة إدارة جو بايدن المالية ومؤسسات وول ستريت، في تطويق تبعاتها. هما في ذات الظنّ الخاطئ الذي يدفع أنصار الرأسمالية المعاصرة إلى التأكيد/ الطمأنة بأنّ فصول مسرح الإفلاس هذا («سيلفرغيت» و«سغنيشر» بعد «سيليكون فالي») مقتصرة على الأسواق الأمريكية وبورصاتها.
في المثال، الذي يصحّ أن يتوارد سريعاً إلى الذهن، ذلك المشهد الذي تابعته اليابان ذات يوم غير بعيد؛ حين أطلّ المدير التنفيذي لشركة «يامايشي» للسندات والأسهم والمضاربات على شاشات التلفزة، فانخرط في بكاء متقطع مرير، وانحنى على النحو الشعائري الياباني وهو يعلن الإفلاس الوشيك للشركة. واكتملت الدراما القصوى حين توقفت الكومبيوترات، وتجمدت المعاملات المالية، وأُطفئت الأضواء في ناطحة السحاب حيث مقرّ الشركة. نهاية حزينة لا ريب، وكان المشهد، المسرحي بامتياز، جديراً بأكثر تراجيديات وليام شكسبير توتراً ومأساة؛ مع فارق حاسم هو أنّ المشهد كان واقعياً 100٪.
تلك كانت الشركة التي تحتلّ المرتبة الرابعة في لائحة كبريات بيوتات السندات المالية الخاصة في اليابان، وعراقتها تعود إلى عام 1897، ولها فروع في 31 عاصمة رأسمالية، بكادر من المستخدمين يتجاوز السبعة آلاف موظف. ذلك كله لم يحصّنها ضدّ سلسلة من الفضائح المالية، وسلسلة ثانية من تقلبات أسعار الأسهم، وسلسلة ثالثة من صعوبات تأمين التمويل، الأمر الذي أفضى إلى خسارة صافية مقدارها 52 مليار دولار أمريكي، وإلى إعلان الإفلاس والإغلاق.
أوّل الدروس وراء ذلك الانهيار الدراماتيكي للشركة اليابانية هو أنّ العمالقة قد يجدون أنفسهم بغتة في عراء مطلق، بلا سند أو كفيل أو ضامن، قاب قوس واحد من الهاوية. البنوك المركزية في أوروبا وضعت يدها على قلبها، وأبدت مشاعر «التعاطف» ثم التزمت الصمت. الشركاء الأمريكيون ضنّوا حتى بمشاعر التعاطف. وبنك «فوجي» الذي رعى مصالح الشركة المفلسة منذ عقود وربح على ظهرها ومعها مئات الملايين، نفض يده في نهاية الأمر وأعلن مسؤولوه أنهم لا يستطيعون القيام بأيّ شيء لإنقاذ الموقف.
ثاني الدروس أنّ التشدّق الليبرالي حول ضرورة توطيد الاستقلالية المطلقة للمؤسسة الخاصة مقابل الدولة والإدارة المركزية، تلقى لطمة قاسية، لأنّ الجهة الوحيدة التي كانت قادرة على انتشال «يامايشي» من الهاوية هي وزارة المالية اليابانية؛ تماماً كما اتضح أنها الحال اليوم مع مصرف «سيليكون فالي» وقريناته المنهارات. وهنا أيضاً، في المثالين الياباني والأمريكي، اتضحت محدودية هذا الدور لأنّ الخزينة العامة ليست مضخة مليارات لا تنضب؛ بدليل عجز الحكومة اليابانية عن إنقاذ بنك «تاكوشوكو» وشركة سندات «سانيو» من إفلاس مماثل وقع خلال الفترة ذاتها؛ وتنصّل المصرف المركزي الأمريكي، اليوم، من مهمة إنقاذ المصارف المفلسة لقاء ضرورات رفع أسعار الفوائد ومجابهة التضخم.
وأما ثالث الدروس فهو مفارقة مزدوجة وخارج حدود اليابان، إذْ كانت فانكوفر الكندية تشهد انعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسيفيكي (أبيك)؛ وفي الآن ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي وثيقة جديدة حول برنامج التعديل الهيكلي، أي «وصفة» الإصلاحات الإلزامية التي يفرضها الصندوق على الدول النامية كشرط مسبق للإقراض والإعانة، والتي تحثّ على منح المزيد من الاستقلال للشركات الخاصة، والمزيد من إقصاء الدولة بعيداً عن الحياة الاقتصادية!
العالم تابع ردود أفعال غريغ بيكر، المدير التنفيذي لشركة «سيليكون فالي» الأمّ، فلم يتضح أنه ذرف دمعة واحدة على انهيار مصرفه، بل فعل ما لم يكن سيخطر على بال المدير الياباني لشركة «يامايشي»: لقد استبق الانهيار، منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، فباع من أسهمه الشخصية ما درّ عليه 3,6 مليون دولار أمريكي من الأرباح الصافية. وقبل سنوات، حين أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع قيود التدقيق على المصارف، أنفق بيكر ما يعادل نصف مليون دولار لشراء الذمم في الكونغرس وتسهيل تمرير التشريعات التي تجعل المصارف حرّة طليقة. وإذا كان المعمار الأخلاقي في قلب الثقافة الرأسمالية اليابانية قد أتاح انهمار دموع المدير التنفيذي لشركة «يامايشي» فإنّ المعمار الأخلاقي النظير في الثقافة الرأسمالية الأمريكية لم يُعفِ غريغ من تلك الانحناءة الشكسبيرية فحسب، بل أعطاه الحقّ في أن يدير ظهره ويغادر المسرح وكأنّ شيئاً لم يكن… ولعلّ براءة الأطفال داعبت عينيه أيضاً!
وكان فريدريك إنجلز، شريك كارل ماركس في رصد ملامح الشبح الشيوعي الذي أخذ يحوم في سماء أوروبا وأرضها منذ أواسط القرن التاسع عشر، قد أطلق عبارة نبوئية مدهشة وثمينة في آخر أيام حياته: «ثمة غرابة خاصة في أطوار البرجوازية، تميّزها عن جميع الطبقات الحاكمة السابقة، هي أنها تبلغ منعطفاً حاسماً في صعودها وتطوّرها تصبح فيه كلّ زيادة في وسائل جبروتها، أيّ كلّ زيادة في رأسمالها أساساً، بمثابة عنصر جديد إضافي يساهم في جعلها أشد عجزاً عن الحكم بالمعنى السياسي». وبصرف النظر عن درجة الصلاحية العامة في تشخيص صدر قبل قرن ونيف (توفي الرجل عام 1895) فإنّ المجموعات الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة تبدي الكثير من هذا الميل؛ فكيف الحال في مجتمعات الاهتداء الهستيري العجول إلى فضائل الرأسمالية العتيقة وآلامها وآمالها.
وكان الأمريكي فرنسيس فوكوياما قد أعلن نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية السياسية والاقتصادية في معركة ختامية لن تقوم بعدها قائمة لأية إيديولوجية منافسة. بعد خمس سنوات أصدر كتابه الثاني الذي يبشّر بنهاية الاقتصاد الوطني وولادة التعميم العالمي لاقتصاد كوني واحد عماده «الثقة» تدور من حوله أفلاك اقتصادية أصغر أو هي ليست بالاقتصاد إلا لعدم توفّر مصطلح بديل يصف طبيعتها. ولكنّ فوكوياما، في الكتاب الأوّل كما في الثاني، كان قد أساء قراءة هوية «الرجل الأخير» أو الرأسمالي خاتم البشر، الذي سيرث الأرض بعد طيّ صفحة الحرب الباردة. الأشباح التي أخذت تجوس من جديد ليست بالتأكيد في عداد ذلك الرجل، فكيف إذا تسارعت الانهيارات في قلب الولايات المتحدة، وتعاقب انهيار المصارف التي تستقبل ودائع «الرجل الأخير» إياه!
انقضت، اليوم، 34 سنة على مقالة فوكوياما التي ساجلت بأنّ التاريخ لعبة كراسٍ موسيقية بين الإيديولوجيات (عصر الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم الآسيوية، ما بعد الحداثة…)؛ وقد انتهى التاريخ وانتهت اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (سقوط جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة) أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي تُعزف الآن هي تلك الخاصة بالرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق. ليس في استعارة لعبة الكراسي الموسيقية أيّ إجحاف بحقّ أطروحة فوكوياما، بل لعلها أفضل تلخيص للتمثيلات الكاريكاتورية التي وضعها الرجل لعلاقة البشر بالتواريخ، ولتأثير البنية الفوقية (الإيديولوجيا والنظام الفكري) على البنية التحتية (الاقتصاد والنظام الاجتماعي) وعلى «ولادة إنسان لا حاجة له بالتاريخ لأنه ببساطة خاتم البشر»!
أم لعله في حاجة ماسّة إلى ودائعه المضيّعة في خزائن نهاية التاريخ، خاصة إذا افتقر إلى ما يملكه غريغ بيكر من «بصيرة» تجعله يتنقل بين الكراسي الموسيقية فلا يسحب ودائعه في التوقيت القاتل فحسب؛ بل يتكسب من سحبها، أيضاً وأيضاً!
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي