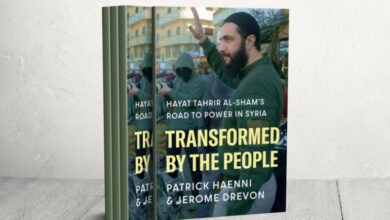الأوراق المفقودة: السير الذاتية الشامية وحلاق المدينة/ محمد تركي الربيعو

قبل الحديث عن علاقة الدمشقيين في القرن العشرين بحلاق المدينة (البدير الحلاق) المولود في القرن الثامن عشر وصاحب اليوميات الشهيرة عن المدينة وأهلها، من المناسب رواية قصة عن مذكرات المثقف السوري الراحل نجاة قصاب حسن.
أصدر حسن سيرته في نهاية الثمانينيات بعنوان (حديث دمشقي). وبعد فترة أصدر الجزء الثاني منها بعنوان (جيل الشجاعة). وفي مقدمة الجزء الثاني من سيرته، التي حاول فيها السير على خطا حلاق دمشق (البدير) بالكتابة عن المدينة، يذكرُ حسن إنجازه لجزء ثالث من مذكراته بعنوان (الغليان) وبما أنها واحدة من أمتع السير التي كُتبت عن المدينة، كان من الضروري الاطلاع على الجزء الثالث، للأسف، بعد سؤال أحد الأصدقاء الباحثين لورثة حسن، تبيّن أنّ الجزء الثالث لم يُطبع أو يُنشر رغم مضي قرابة 30 عاماً على إعداده! وأنّ العائلة ذاتها أعاقت صدوره بسبب انشغالات أولادها.
وبالعودة لموضوع الكتاب السوريين والبدير الحلاق، يرجع سبب رواية الحكاية الأخيرة إلى أنّ سيرة الراحل نجاة قصاب قد تعدّ واحدة من أهم النماذج التي يمكن الأخذ بها عند قراءة العلاقة بين الكتاب الدمشقيين وحلاق مدينتهم، فعلى امتداد سنوات بقي نجاة حسن وكثير من كتاب المدينة يحاولون الربط بين ما يكتبونه وما كتبه البدير عن دمشق ويومياتها في القرن الثامن عشر. ولعل هذا الربط لن يتوقف في التعبير عن نفسه في ذهنية الكتاب، كما نرى مؤخرا في المقالات والتعليقات حول نصوص اليوميات في دمشق بعد الحرب، إذ غالبا ما رُبِط بين هذه اليوميات ويوميات البدير. كما أنّ هناك من تقصّد هذا الربط في يوميات تعود لفترات أقدم، وهذا ما نراه مثلا في الكتاب الذي جمعه محمد مطيع الحافظ لبعض الأخبار المنشورة عن الدمشقيين في بدايات القرن العشرين. وقد جمعها الحافظ تحت عنوان «حوادث دمشق اليومية» في إشارة وتذكير بنص البدير «حوادث دمشق اليومية». ولذلك يبدو أنّ بعض المثقفين السوريين، ولاسيما الدمشقيين، بقوا مولعين بقصة هذا الربط ، وهو ما يوحي بأنّ للمدينة تقاليد قديمة وراسخة في الكتابة عن حياتها وأهلها.
عمل نجاة حسن قرابة ثلاثين عاماً في المحاماة، ما وفّر له فرصة الاقتراب أكثر من حياة الناس ومشاكلهم. كما قدّم برنامجا اذاعيا (المواطن والقانون) في الخمسينيات تلقى خلاله عشرات الرسائل من الناس (ولا نعلم ما مصير هذه الرسائل؟). يرى حسن أنّ هذه التجارب ساعدته على التحول إلى قصاص شعبي في سيرته، لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، لماذا قرّر هذا القصاص (في تسعينيات القرن العشرين) ربط نفسه بالبدير (القرن الثامن عشر)؟ وهل فعلا كان أسلوبه شبيها بأسلوب البدير في تدوين يومياته؟ أم أن نجاة حسن، ورغم هذا الربط، تأثّر في الواقع بكتّاب دمشقيين آخرين قريبين من جيله، بينما بقي في كتاباته يعلن أنه من سلالة الحلاق الكتابية.

دمشق الثلاثينيات
قبل الإجابة عن بعض هذه الأسئلة، لنرى مدينة دمشق بعيون نجاة حسن. تبدو معه دمشق في الخمسينيات مدينة للمهاجرين، ونرى ذلك من خلال حديثه مثلا عن الشركس في حي المهاجرين، وعن دور الأرناؤوط في مهنة الحطابة، وعن حنابلة فلسطين في حي الصالحية. يذكر أنه وُلِد في بستان الكركه الواقع خلف سوق ساروجة. وكان الدمشقيون في أغلبهم ينامون على الأرض، بينما الأغنياء فقط ينامون على سرير من النحاس الأصفر. وعمل عمه ضابطا في إسطنبول خلال الحرب العالمية الأولى، ما ساهم في إدخال بعض التعديلات على المنزل لاحقا. فقد أجبرهم على أن يكون لكل فرد من العائلة صحنه وملعقته، بدلا من الأكل من صحن كبير واحد. لا ينسى في ما يذكر موضوع اللباس واعتماد الطربوش والشروال والقمباز من الشرائح التقليدية، بينما ارتدى الموظفون في الأربعينيات اللباس الإفرنجي من بنطلون وجاكيت وربطة عنق وصدرية وطربوش وحذاء (صباط).
من القصص اللافتة على صعيد اللباس أيضا، ما يتعلق بلباس النساء. فقد كن يلبسن الإزار الأبيض ثم بعد مدة لبسن الملاءة السوداء (ربما في فترة الفرنسيين). وفي الوسط الأقل تشددا، ظهرت الملاءة السوداء ذات القطعتين والمنديل المنفصل.. لاحقا ظهر ما يُسمى باللبس على الطالع أي على الموضة، فلبست النساء معطفا وفوقه منديل فقط يلف به الرأس، ثم بدأت تقصر المعاطف. وهكذا بالتدريج إلى أن صار بعض الناس يقولون إننا لا نعرف هل البنت التي تمشي في الطريق تزفُّ هذه اللحظة إلى عريسها أم لا. يبدو نجاة، في هذا الوصف، قريبا فعلا من البدير، الذي وصف النساء اللواتي يسرن في الشارع بالشلكات. بينما بتن يحملن مع تقدم الزمن وسياقاته (زمن نجاة) وصفا آخر (عروس تبحث عن زوج). ورغم أنّ هذا الوصف يبدو أكثر تهذيبا ولطفا من المفردات التي اعتمدها البدير، لكنه يحتفظ كذلك بتلميحات جنسية مبطنة؛ فالشلكة تبحث عن متعة ما؛ وأيضا الفتاة العروس؛ فهي تخرج أيضا باحثة عن رجل يتزوجها وينكحها وفق ألسنة العامة، وهي مقولات يتردد صداها إلى أيامنا هذه.
من القصص التي يرويها أيضا عن الدمشقيين أنهم إذا عرفوا أنّ الطاهية بشعة لم يأكلوا طعامها. وأنه لم تكن هناك بندورة، والدجاج لقلته كان يُعدّ من أفخر الأطعمة. ولحم البقر قلما يُؤكل. ولا نعلم ما الذي كان سيقوله لو عاش لهذه اللحظة، وعلم أنّ الأكلات التي ذكرها لم تعد متاحة للجميع، في ظل الفقر الذي يُجهِزُ على ما تبقى من السوريين. ما يستوقف القارئ في أسلوب حديث نجاة حسن أحيانا عن الطعام في المدينة، أنه يظهر وكأنه يقتبس أسلوب وأفكار أشخاص آخرين كانوا أقرب لزمنه مثل، فخري البارودي (مؤلف كتاب عن الطعام ولا بد أن حسن قد قرأه). كما يُلاحظ هذا القرب عندما يتحدث عن نداءات الباعة، مما يذكرنا بأحد نصوص الشيخ محمد القاسمي عن الباعة، إلا أنه لا يشير لهم، بل يربط نفسه في كل موضوع بيوميات البدير.
بدران دمشقيان
لعل الإجابة عن علاقة السوريين بالبدير، يمكن فهمها أكثر في حال فهمنا كيف نظروا ليوميات البديري نفسها ولأسلوبه في الكتابة اليومية. في سيرة نجاة حسن، لا يبدو أنه يشابه صاحبه البدير على صعيد الأسلوب في الكتابة. فهو، وإن حاول الربط بينهما، لم يكن يعني بالضرورة نقل أسلوب الجد في كتابة اليوميات عبر هذا الربط، وإنما نقل روحه في ما يتعلق بالحفاظ على تقاليد المدينة وأهلها، ولذلك يبدو أنّ نجاة وقسم من المثقفين الدمشقيين (خيري الذهبي) اعتقدوا أنّ مجرد الكتابة عن المدينة وطقوسها، تجعلهم أقرب للبدير في الكتابة. هنا نصبح أمام بدرين، أو بديرين، الأول الذي دوّن وكتب عن دمشق القرن الثامن عشر، وهو شخصية محافظة، حاول رسم صورة عن أحداث المدينة وتقلباتها (ويكفي الاطلاع على نصوص دانا السجدي وسامر عكاش في هذا الشأن). أما البدير الثاني، فهو شخص آخر يظهر في القرن العشرين بوصفه الشخص الذي حافظ على تقاليد المدينة، ولذلك لا تكمن أهميته هنا في أسلوب قراءته وكتابته عن المدينة، وإنما تأتي من كونه بات مرجعا روحيا لكل مثقف يرغب بالكتابة والدفاع عن تقاليد العامة.
ولعل فكرة الكتابة عن تقاليد المدينة والعامة، مقابل الكتابة النخبوية، نراها حتى عند نجاة حسن بشكل واضح ومؤرق أحيانا. فهو، خلافا لشخصية البدير، لم يكن في زمنه شخصا عاما، بل هو من خريجي كلية الحقوق، وعمل مدرسا ومذيعا. وبالتالي ليس في هذه السيرة ما يذكر بسير العامة العاديين أو حتى البدير (ربما بدر الدين الشلاح في بداياته كان عاميا بالمعنى البدير). مع ذلك نرى نجاة يصر في الجزء الثاني على التذكير أنه مؤهل لكتابة التاريخ بطعم خاص «لأنني من وسط شعبي متوسط كثير الاختلاط بالناس. فقد عاشرت البسطاء وخالطت المجرمين». ولعل اعتماد هذا الأسلوب في خلق مرجعية كتابية، يعكس رغبة نجاة أيضا بالرد على شريحة مثقفة سورية (يسارية) كان يوما جزءا منها، قبل أن يخرج من عباءتها. فخلال فترة الثمانينيات والتسعينيات (وإلى يومنا هذا) لم تستلطف هذه النخب هذا النوع من الكتابات عن التقاليد والثقافة الشعبية، وظلت تبدي اهتماما أوسع بالتواريخ العالمية والأيديولوجيات. بينما حاول نجاة قصاب الرد على هذه الرؤية المشغولة بالأيديولوجي، بالتركيز على المحلي واليومي.
دمشق بعيون شيوعي قديم
ولم يعن بالضرورة، اهتمام نجاة حسن بالمحلي والشعبي، السير وراء معتقدات هذا الشعبي والقبول بها. وإنما نرى أن نجاة بقي يساريا أحيانا، وهو يقرأ في هذا التاريخ الشعبي. انضم نجاة إلى الحزب الشيوعي في فترة الخمسينيات، مع ذلك لا يذكر تفاصيل في سيرته عن هذه التجربة، ويكتفي بالعبارة التالية: «كانت رغبتي في العدالة الاجتماعية قد قادتني نحو أحد هذه الأحزاب» وقد بقي في الحزب لعشر سنوات، ثم «بدأت أشعر بشيء يثقلني، فآثرت التنحي». لكن، وعلى الرغم من هذه القطيعة الحزبية، بقيت أفكار هذه المرحلة تحكم رؤية نجاة وهو يكتب في الثمانينيات عن دمشق. فعلى صعيد القرابات، يشير إلى أنّ عدم تفضيل الدمشقيين الزواج من امرأة ثانية جاء من باب العامل الاقتصادي. في حين نرى مثلا أنّ ما منع الدمشقيين من الزواج تحكمه مبررات أخرى كذلك، إذ يقول المعلم الدمشقي محمد الحافظ الصيداوي، الذي عاش في فترة البدير الحلاق، في هذا الشأن «أندم من هذا وأشقى وأعلى في مراقي النحوس وأرقى، من تزوّج اثنتين وحصل على بليتين ولزمه شر الليلتين ووقع في الندامة، ولبس ثوب الغرامة، وضاقت معيشته، وكدرت عيشته». وبالتالي يبدو أن هناك مزاجا عاما دمشقيا لم يشجع على الارتباط بزوجة ثانية، وهو مزاج نراه في مدن أخرى مثل حلب وبيروت. كما نراه، خلافاً لصديقه البدير، لا ينظر للطقوس الصوفية بوصفها جزءا من عالم رمزي أوسع، بل عبارة عن خرافات شعبية. وهذا مصطلح يوحي بقراءة يسارية بقيت تحكم نظرة نجاة حسن لبعض زوايا الشعبي في يوميات دمشق القرن العشرين.
الجيل الشجاع
تروي الأكاديمية والمسرحية السورية حنان قصاب حسن (ابنة المؤلف) تفاصيل عن علاقتها بالكتاب ومكتبة والدها. ومما تذكره في هذا السياق، تأثّرها في فترة الستينيات بكتاب فرانز فانون «معذبو الأرض». ويبدو من كلامها أّن والدها كان حريصاً على تعريفها بالقراءة، ولذلك يخيل لنا أنها ربما تعرفت على نص فانون للمرة الأولى في مكتبة منزلها. ولعل الشيء المهم في هذه القصة، أن عنوان الجزء الثاني من سيرة والدها (جيل الشجاعة) في إشارة للجيل الذي واجه الاستعمار، يوحي بهذه اللمسة الفانونية. مع ذلك، لا يمكن البت بمدى تأثر نجاة حسن بفانون وكتاباته، دون قراءة لنصوصه في سياقها التاريخي.
يروي في هذا الجزء تفاصيل سوريا في العشرينيات على صعيد العلاقة بالانتداب الفرنسي إلى فترة الاستقلال الوطني. ولأنّ نجاة حسن لم يحضر هذه اللحظة، حاول الاعتماد على بعض المراجع. لكن اللافت أنه قرر القطيعة مع رؤية جيله من المثقفين، وأسلوبهم في الكتابة، من خلال اعتماده على الذاكرة الشفوية بدلا من النصوص التقليدية فقط. ففي تأريخه لحادثة دخول ثوار دمشق قصر العظم (مقر الإدارة الفرنسية) في عام 1925، يعتمد في رواية هذه الحادثة على ما دونه بدر الدين الشلاح نقلا عن والده. كما اعتمد في تأريخ بعض الأحداث الأخرى على ذاكرة والده. ولا يعني هذا عدم استعانته بجهود باحثين في هذا الشأن، وهذا أمر لا ينفيه عندما يؤكد تأثره بصديقه شاكر مصطفى، لكنه في اعتماده على الروايات الشفوية، كان يقطع مع رؤية ثقافية سورية، لا تولي للشفوية وسيرها مكانة تذكر، وهذا ما سيشهد تحولا بعد 2011. يُحسب لنجاة في الجزء الثاني من سيرته، أنه أتاح لنا فرصة للتعرف على أوضاع الكتابة والمثقفين في دمشق في النصف الأول من القرن العشرين. ومن هنا تأتي أهمية وضرورة طباعة الجزء الثالث من سيرته بعد مرور ثلاثة عقود على كتابتها، وهي مسؤولية لا يتحمل وزرها ورثته فحسب، بل أيضا كل المؤسسات السورية العاملة في مجال الثقافة والذاكرة والمجتمع، وما أكثرها هذه الأيام.
كاتب سوري
القدس العربي