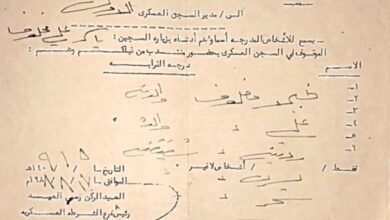غرب المالكي / جنوب الحجر الأسود… عن سوريا التي اعتقدنا أننا نعرفها / شكري الريان

العوالم المختلفة لأحياء في المدينة نفسها، كانت موجودة قبل الحقبة الأسدية السوداء في سوريا، وهي كذلك كانت موجودة في أوروبا بالتأكيد، ولكن مع فارق، أن الدولة في أوروبا، وبعد مخاض عسير وثورات وحروب أهلية ودماء كثيرة سالت، استطاعت في النهاية الوصول إلى مرحلة باتت فيها موجودة بالدرجة الأولى لتجسير تلك الفوارق.
أعيش في حي اسمه “غيريشاخن” في واحدة من المدن القريبة من العاصمة السويسرية بيرن. يكفي للحقيقة أن تذكر اسم الحي أمام أي مستمع سويسري، حتى يطالعك الأخير بابتسامة عريضة، هذا إن لم يستغرق في الضحك.
حدث الأمر معي مرة، عندما قدمت نفسي أمام الحضور في قاعة ممتلئة في ورشة عمل أدبية في بيت الثقافات في زيورخ، عندما ذكرت اسمي وقلت إنني قادم من “غيريشاخن”، تعالت الضحكات في جنبات القاعة. مرد الضحك لم يكن لأنني لاجئ ونسبت نفسي إلى حي سويسري، والحي في كل الأحوال معروف بأن اللاجئين والمهاجرين يشكلون 35 في المئة من تعداد سكانه، أي كان من الطبيعي أن أنسب نفسي إلى “مخيم اللاجئين” هذا؛ الضحك كان مرده أن المكان اشتهر في سويسرا كلها بسبب فيلم وثائقي، حقق نجاحا كبيراً ” Of Sins, Sofas and Sausage” أو “Gyrischachen- von Süden, Sofas und Cervelats”.
تناول الفيلم المكان وعجائبه، في محاولة للخروج من النظرة المسبقة للمكان بصفته “غيتو”، فكانت العجيبة الأهم، هي أن مكاناً لا تتجاوز مساحته الفعلية الكيلو مترين المربعين، وتعداد سكانه لا يتجاوز الألفين وخمسمئة، يبلغ عدد اللغات المستخدمة فيه أكثر من 42 لغة، البناء الذي أقطنه في الحي، وفيه ثمانية شقق، يبلغ عدد اللغات المتداولة فيه السبع!.
بمعزل عن حي “غيريشاخن” ومعجزاته و حيويته الهائلة بالتحديد (وهذا أمر لا بد من الإشارة إليه، حتى من شخص مُتعَب دائماً، ككاتب هذه السطور)، فإن ما لفت انتباهي، أنا اللاجئ القادم من “أقدم مدينة مأهولة عرفها التاريخ”، هو حي آخر وطبيعة علاقته بحينا. هو ذلك الحي المجاور الموجود على تلة مطلة على حينا، حي “غيريسبيرغ شتراسه”.
هناك، حيث سعر أية فيلا في هذا الحي لا يمكن أن يقل عن المليون ونصف المليون فرنك سويسري، وكل الفيلات هناك مملوكة، وليست مستأجرة، يقيم بشر يشبهون في معظم تفاصيل حياتهم، الرئيسية منها على الأقل، البشر الذين يعيشون على بعد أقل من مئتي متر في حي “غيريشاخن”، حيث يعيش جزء لا بأس به من سكان حيّ هذا على الإعانات الاجتماعية.
في “بورغدورف”، المدينة التي أقيم فيها وتجمع الحيين، وأحياء كثيرة تشبههما، يمكن القول إن “المسافات” التي تفصل أحياء المدينة المختلفة، وسكانها، عن بعضهم البعض، لا تتعدى فعلياً تلك المسافات المحددة على خرائط غوغل، أو أي نوع من الخرائط يمكن أن يخطر في البال، بما فيها تلك الخرائط المتعلقة بـ “أنماط حياة السكان”.
وهذا بالضبط على عكس الحياة في أحياء دمشق، حيث المسافات لا يمكن أن تقاس بسهولة أبداً، لا بواسطة غوغل ولا بواسطة أي مقياس معروف لحياة البشر الطبيعيين في بلاد يفترض أنها بلادهم جميعاً.
في “بورغدورف”، أو أية مدينة أخرى في سويسرا (هل يمكنني أن أكون جريئاً هنا، إلى حد ما، وأقول “في دول في أوروبا عموماً”؟!)، يذهب سكان جميع الأحياء، أياً كان مستواها الاجتماعي، إلى المولات ذاتها، ويتناولون الطعام في المطاعم ذاتها، أقله وجبة الغداء ضمن يوم العمل، ويذهبون إلى طبيب العائلة نفسه والمستشفيات ذاتها، والأهم، أولادهم يتشاركون الصفوف ذاتها في المدارس ذاتها. وإن كانت هناك فوارق، فهي لا تظهر في ما يمكن أن يخطر في البال، للوهلة الأولى، من مظاهر البذخ المختلفة. حتى السيارات الفارهة، يمكن القول إن نصيب سكان “غيريشاخن” منها أعلى من نصيب جيرانهم في “غيريسبيرغ شتراسه”! (يمكنني الحديث عن هذه النقطة بثقة كبيرة في ما يخص اللاجئين السوريين على الأقل، العاملين منهم بالذات، وهم الآن النسبة العظمى بينهم للمناسبة… السيارة، الفارهة بالتحديد، لمن استطاع إليها سبيلاً، عقدة العقد بالنسبة إلهم! ربما مرد هذا الأمر إلى أنهم دفعوا من عرقهم ودمهم تكاليف السيارات الفارهة التي اقتناها الأسديون وأعوانهم وأولادهم، وكان متاحاً لهم أن يدوسوا بقية السوريين بها في أية لحظة).
أعيش في حي اسمه “غيريشاخن” في واحدة من المدن القريبة من العاصمة السويسرية بيرن. يكفي للحقيقة أن تذكر اسم الحي أمام أي مستمع سويسري، حتى يطالعك الأخير بابتسامة عريضة، هذا إن لم يستغرق في الضحك.
مظاهر البذخ في الأحياء الغنية في سويسرا يمكنها، إن تجاوزت النمط المعماري الخاص بكل حي، وهذا أمر بالتأكيد بارز جداً في أناقة فيلات حي “غيريسبيرغ شتراسه”، والأحياء التي تشببه، يمكن أن تمتد، في أقصى حدودها، إلى أماكن تمضية الإجازات السنوية، أي بعيداً عن البلاد التي هي فعلاً لجميع ناسها. بينما الأمر في دمشق مختلف تماماً. لا يمكننا أن نتجاوز حقيقة العوالم المختلفة لدرجة التباين التام، ليس فقط في النمط المعماري، بل وأيضاً في كل تفاصيل حياة السكان، بين غرب المالكي، أبو رمانة، مزة فيلات… والدحاديل، نهر عيشة، الحجر الأسود… وقس على هذا كل أحياء المدن السورية، “العريقة” منها بالذات، من دون أي استثناء.
هذه الفوارق، العوالم المختلفة لأحياء في المدينة نفسها، كانت موجودة قبل الحقبة الأسدية السوداء في سوريا، وهي كذلك كانت موجودة في أوروبا بالتأكيد، ولكن مع فارق، أن الدولة في أوروبا، وبعد مخاض عسير وثورات وحروب أهلية ودماء كثيرة سالت، استطاعت في النهاية الوصول إلى مرحلة باتت فيها موجودة بالدرجة الأولى لتجسير تلك الفوارق. ليس بالتأكيد لخلق نمط واحد ممتثل بين السكان، بل لجعل الجميع، أينما كان سكناهم، يشعرون بأنهم ينتمون إلى الحيز العام ذاته، المفتوح لهم جميعاً بمختلف وجوهه، ليلونوه ويغنوه ويعطوه روحه وملامحه، تماماً على عكس الحال في ظل الظلامية الأسدية المطلقة.
الفوارق هذه في سوريا، وكل أشكال الفوارق والاختلافات الممكن تصورها، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، حتى على مستوى علاقة الأفراد ببعضهم البعض، وكأفراد فقط، تم استثمارها وتسعيرها فقط للوصول إلى نتيجة واحدة: جعل تلك الظلامية الأسدية مطلقة السلطة أبدية الوجود لا تُمس ولا يمكن أن تُمس بأي حال من الأحوال. من أين أتى هذا السعار كله؟! هذا موضوع لبحث آخر سيتناول الأسدية بصفتها ديناً، وله مجاله المنفصل. ما يعنينا هنا، أن “دولة” الأسد كانت موجودة ليس بصفتها أداة تجسير بين فوارق سابقة على وجودها، بل على العكس تماماً، وذلك فقط لخلق نمط واحد بين السكان: ذلك الشخص الممتثل لما تلقنه إياه السلطة، من باب الخوف وليس من باب الاقتناع، شديد الارتياب وعديم الثقة بكل ما يحيط به، بمن فيهم أقرب الناس إليه.
عندما قامت ثورة 2011، قامت بالذات ضد هذا الخوف، ولخلق فضاء عام مشترك لجميع السكان، من غرب المالكي إلى جنوب الحجر الأسود، ولكنها هُزمت. ليس فقط لأن النظام وجد من يحميه من القوى الإقليمية والدولية (التركيز على هذه النقطة بالذات وحدها لتبرير هزيمة الثورة، مشكلة كبيرة يجب أن نحاول تجاوزها لفهم حقيقة ما حصل معنا)، بل أيضاً لأن “المجتمع” السوري، بكل مكوناته، لم يكن مهيئاً للدخول في هذا الفضاء العام قافزاً فوق تلك، الاختلافات، الفوارق، الحواجز… سمها ما شئت، هي في نهاية المطاف تشير إلى عوالم مختلفة ما كان من الممكن أن تلتقي من دون ثورة… تلك التي لم يكن انتصارها في مصلحة جميع السوريين في ما يبدو. وعندما أتحدث عن أولئك الذين بقيت مصالحهم مع النظام، لا أقصد فقط مواليه من طائفته، بل أيضاً كثراً من سكان… “غيريسبيرغ شتراسه” الدمشقي، الحلبي…
هذه حقيقة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ليس فقط لنفهم ما هي أسباب هزيمة ثورتنا، بل وأيضاً لنفهم ما هي الآفاق الممكنة أمامنا بالاستناد إلى ما هو موجود على الأرض، بحيث لا تخرج العراضة في إدلب، والعرس فعلياً في السويداء!
الحديث عن “سوريا”، بات يستلزم سؤالاً مهماً، يوجه الى المتحدث: أي سوريا تقصد، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً؟! هناك “سوريات” متعددة، وبالاستناد إلى ما يمكن تصوره من خلفيات للخلاف، طبقياً، طائفياً، عرقياً واقتصادياً؛ والأهم مصالح بنيت على مدار عقود، ومن النظام الأسدي بالدرجة الأولى، وبعمل دؤوب ومركز لجعلها أصلب في مواجهة أية تحديات.
وهنا يطل سؤال آخر، مرتبط بما سبقه: ما الذي فعله السوريون، جمهور ثورة 2011 بالذات، لخلق تلك المصالح التي تجمع بينهم وبين بقية السوريين؟! ليس في ظل استبداد أسدي ماحق، هذا كان مستحيلاً في كل الأحوال، بل في ظل معطيات جديدة خلقتها الظروف التي ولدتها الثورة، رغم هزيمتها.
هناك ما لا يقل عن عشر سنوات منذ الهزيمة المعلنة لثورة السوريين (تراجع أوباما عن خطه الأحمر وإعطاء الضوء الأخضر لنظام الأسد بقتل السوريين بكل أنواع الأسلحة، باستثناء السلاح الكيماوي). وجد السوريون أنفسهم خلال تلك السنوات في مواجهة ظروف أخرى تماماً، وجزء لا بأس به منهم أصبح خارج قبضة الأسديين، ويفترض، بعد الذي خبرناه في ظل ذلك الظلام الدامس، ألا ندع الفرصة لقبضات نتنة أخرى أن تطبق على أنفاسنا، ماذا فعلنا لندفع الأحداث في بلادنا، ولو ربع خطوة، بعيداً عن “بكائية الياسمين”؟!
تلك الأسئلة كلها تتطلب للإجابة عنها أن نقف على أرضية، ليست مشتركة، فهذا يبدو أننا بحاجة إلى وقت لتأسيسه، ولكننا أيضاً بحاجة إلى أرضية واضحة لفهم تاريخنا، القريب منه بالذات، بحيث ندرك أن “سوريا المتخلية” ليست حكراً على المستقبل فحسب، هي تمتد أيضاً إلى ماضينا الذي يجب أن نعيد قراءته بعين مختلفة تماماً عما تعودناه. وجزء هائل مما تعودناه، بالنظر إلى بلادنا وتاريخها، فرض علينا فرضاً. وأن نستعين بما بدأنا نراه ونخبره ونلمسه بأيدينا في عوالم بتنا نعرفها، لأنها متاحة ومفتوحة وسهلة القراءة على رغم التنوع الهائل، ثقافياً وعرقياً وطائفياً حتى (عدد الطوائف، من مختلف الديانات، في سويسرا يتجاوز 13 طائفة)؛ عوالم جديدة بتنا نعرفها أكثر من العالم الذي يفترض أننا ولدنا وعشنا معظم سنوات أعمارنا فيه. وكنا، من بقي منا على قيد الحياة، على وشك الموت في أية لحظة خلال ثورة قامت لنعيد امتلاكه. ربما الخطوة الأهم للوصول إلى هذا الهدف، هو أن نعرفه أكثر. وربما، عبر محاولة المعرفة هذه، نكون قد أكدنا لأنفسنا، قبل الجميع، أن ما بدأناه في 2011 لم يهزم تماماً، ولم ينته بعد.
درج