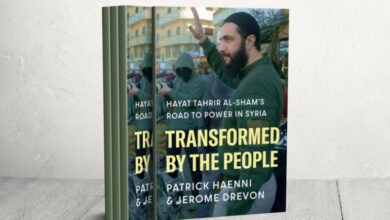الثقافة بوصفها خديعة/ راتب شعبو
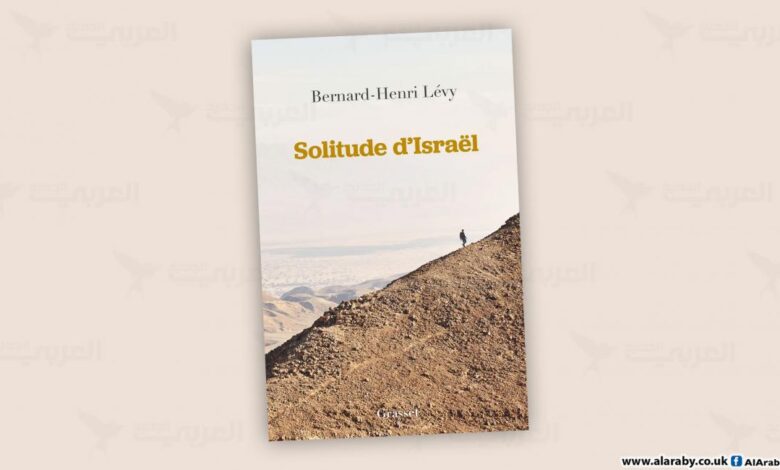
30 مارس 2024
الغنى أو “التطور” الثقافي الذي يحصّله بعضهم، لا يعدو كونه امتلاك وسائل إضافية للدفاع عن مواقف ومنظورات ثابتة لديهم تشكلت قبل “الثقافة”. في هذه الحالات، لا تخدم الثقافة في تعديل منظور الشخص وتحسين رؤيته إلى العالم وتوسيع أفقه بأبعاد إنسانية نزيهة وعادلة، كما ينبغي أن يكون دور الثقافة، بل تخدم في تمكين الفرد من الدفاع عن مواقف قبلية يمكن أن تكون مغرقةً في التخلّف أو التحيّز أو العنصرية. هذا ما يمكن وصفه بالغش الثقافي، أن تجد شخصاً يستخدم ثقافة عالية للدفاع عن مواقف وضيعة، أو استخدام المقدرة الثقافية لقلب الحقيقة والتلاعب بالحقائق بما يخدم وضاعة المواقف التي يتبنّاها “المثقف”.
تشبه هذه الحالة التحوّلَ من جرّ المحراث بقوة الثيران إلى جرّه بالطاقة الكهربائية مع الحفاظ على السكّة الواحدة الأصلية نفسها. أي ألا يرافق تطوّر الطاقة تطور في الأداة.
هل يكمن السبب في تكلّس المنظورات والمواقف التي نشأ عليها المرء، وامتناعها عن التعديل بالتالي، أم يتعلّق بغياب الرادع الأخلاقي لدى “المثقف”، فيجعل من ثقافته وسيلة لخدمة مواقف وضيعة لديه، أو لخدمة المواقف التي تخدمه؟ في الحالتين، المشكلة قائمة وتتصل ببعد نفسي عند “المثقف”. وفي الحالتين، نكتشف أن الثقافة يمكن أن تكون، لدى بعضهم، وسيلة “رجعية” وأكثر تدنّياً على الصعيد التحرّري والأخلاقي من الحس السليم مفهوماً على أنه ما يمتلكه الإنسان من تقديرات “غريزية” دون الاستناد إلى دعائم ثقافية مكتسبة. وليس الكلام هنا عن ثقافة رجعية، كالتي تدافع صراحة عن الاستعمار أو التمييز العنصري مثلاً، بل هو عن جعل الثقافة “التقدمية” وسيلة رجعية، وسيلة لإظهار الممارسات الاستعمارية والعنصرية على عكس ما هي عليه، فتغدو مثلاً إسرائيل دولة غير استعمارية، وتغدو الإبادة الجارية في غزّة حرباً تحريرية.
وقد شهدت منطقتنا نوعاً آخر من تسخير ثقافة ذات طابع تحرّري لتكون في خدمة مشاريع استعمارية واستيطانية واستبدادية، مثل الاستخدام الصهيوني للفكر الاشتراكي في النصف الأول من القرن العشرين، واستخدام الفكر القومي أو اليساري التحرري كغلاف لممارسات سلطوية وطائفية وعشائرية في البلدان التي كانت تسمّى تقدّمية في النصف الثاني منه.
يعرض الكاتب برنار هنري ليفي في كتابه الصادر أخيراً “عزلة إسرائيل” (solitude d’Israel)، مثالاً فاقعاً على ظاهرة استخدام “الثقافة” وسيلة لتسويغ ومساندة مواقف وممارسات ومنظورات سياسية وضيعة، ليست أقل من تسويغ حروب الإبادة بلغة إنسانية. يدافع الكتاب عن إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنّها ضد الفلسطينيين في غزة، بطريقة لا تكتفي بتبرير الجرائم اليومية التي ترتكب في غزّة، بل يضعها في إطار ضروري وتحرّري. وقد وصف باسكال بونيفاس، أحد الكتاب والمحللين الاستراتيجيين الفرنسيين، هذا الكتاب، بذكاء، على أنه “خدمة ما بعد البيع لجرائم الحرب”، أي هناك مجرمون يرتكبون الجريمة ثم يأتي أمثال برنار ليفي كي يحمي ويحافظ على سوق صانع الجريمة ويصونه.
تشغل إسرائيل وأوكرانيا الموقع نفسه في الكتاب، موقع المعتدى عليه. أوكرانيا التي تعاني من القصف والاحتلال الروسيين، هي في خانة واحدة مع إسرائيل التي تقصف وتبيد وتحتل. لا يجد “الفيلسوف” الذي لقّبه أحدهم بـ”أمير الفراغ” مشكلة في هذه المقارنة. في منظور الكاتب أن ما جرى في 7 أكتوبر غزو، يشبه الغزو الروسي لأوكرانيا. وإذا تجاوزنا عن تسليم الكاتب وتقريره بأن كل مكان تحتله إسرائيل أرض إسرائيلية، وبالتالي، كل عمل ضد إسرائيل هو “غزو”، يبقى أن تماسك هذا المنظور يحتاج ليس فقط إلى تجميد الزمن عند لحظة عملية طوفان الأقصى، بل إلى اختصار الزمن السابق واللاحق في لحظة العملية، بحيث تصبح العملية “حدثاً” وليس مجرّد “حلقة” في سلسلة. يعتمد الكتاب، في تحليله، على مفهوم “الحدث” (événement)، للفيلسوف الألماني راينر شورمان، بوصفه حدثاً مؤسّساً لما بعده، حدثاً لا مثيل له وكأنه ينشأ بلا أسباب أو أنه يتجاوز أسبابه. هكذا ترفع العملية من سياقها التاريخي، تماماً كما رفعت عملية المحرقة النازية، وتخلّد في الذاكرة بطريقة تجعلها تغطي وتسوغ كل جريمة ترتكبها “الضحية” الإسرائيلية مهما عظمت.
في منظور الكاتب، الاستباحة الكاملة لغزّة هي دفاع عن النفس، وينبغي ألا تتوقّف هذه الاستباحة عند حدود رفح. ولا تقف “الثقافة” هنا، بل تضيف، أن إسرائيل في فعلها هذا إنما تعمل على تحرير الفلسطينيين، وتفتح لهم أفق “الدولة الفلسطينية”. أي أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتهجّرهم وتمنع عنهم المعونات… إلخ، خدمة لهم. لا يجد الكاتب ضيراً في قناعته هذه، طالما أن مهمّة اليهود كانت دائماً “إصلاح العالم”، كما يقول، معتبراً أن الإبادة الجارية في غزّة اليوم هي “الممحاة التي تمحو قذارة العالم”، في استعارة لعبارة شهيرة للشاعر الفرنسي لويس أراغون.
يقلق الكاتب “التقدّمي” اعتبار إسرائيل دولة احتلال، ما يعني استفادة الفلسطينيين في نضالهم من الرصيد الأخلاقي العالمي لمقاومة الاحتلال وإدانة المحتل، فيكون الحل “الفلسفي” بأن يعكس ما هو كائن في الواقع ليقول إن دولة إسرائيل هي في الأصل دولة مضادة للاستعمار (anticoloniale)، وإن الكلام عن إدراج عملية طوفان الأقصى في سياق حركة مقاومة، كما وضعها كتّاب كثر، ما هو إلا عكس للحقيقة، والحقيقة أن الحركة التي أطلقت العملية استعمارية.
يتظلم الكتاب بدءاً من عنوانه “عزلة إسرائيل”، في حين أن الموقف العالمي الداعم لإسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى لا سابق له. توافد زعماء العالم لإعلان التضامن مع إسرائيل، وتحرّكت أساطيل القوة الأولى في العالم لمساندة إسرائيل، وبات من يحمل أي رمز فلسطيني في أوروبا وأميركا مهدّداً بتهمة الإرهاب ومعاداة السامية. ورغم التمادي الإسرائيلي في حرب الإبادة التي قضى فيها حوالي 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال (يعتبر الكاتب أن هذه أرقام غير حقيقية لأنها صادرة عن حركة حماس، رغم أن البنتاغون أقرّ بأعداد قريبة) لم يتخذ العالم موقفاً جدّياً ضدها. مع ذلك يشكو الكاتب من عزل إسرائيل، ويتكلم باللغة المتشكية أن العالم دائماً يعتبر اليهود مذنبين… هذا من دون أن يتخلّى “الفيلسوف” عن الحق الفلسطيني، وعن التزامه بحلّ الدولتين إلى حد اعتبار إبادة غزّة (إبادة بشرية وعمرانية) سبيلاً للحق الفلسطيني والدولة الفلسطينية.
العربي الجديد