فايز سارة يحاور أنطون المقدسي: المثقف فقد استقلاله منذ أواخر الستينات وصار تابعاً للحكم
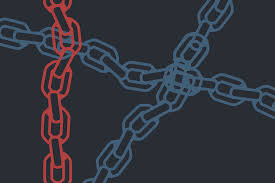
تمر يوم غد في الخامس من كانون الثاني/ يناير، الذكرى التاسعة عشرة لرحيل المفكر السوري أنطون مقدسي، الذي رحل في مستشفى الطب الجراحي بدمشق عام 2005. ويسر (العربي القديم) أن يستعيد بهذه المناسبة هذا الحوار الهام الذي أجراه الكاتب فايز سارة مع الأستاذ المقدسي في دمشق عام 2002، ونشر في العدد الأول من صحيفة (الوسط) البحرينية، لما ينطوي عليه من استعادة توثيقية لمحطات هامة من سيرة المقدسي المثقف والمفكر والفيلسوف، ومن تاريخ سورية وحراك تياراتها الفكرية والسياسية، سواء في عهد الانتداب الفرنسي أو ما بعد الاستقلال وانقلاب البعث (العربي القديم).
***
المفكر السوري أنطون مقدسي (1914- 2005)
ماذا ينتظر الإنسان، وقد تجاوز الثمانين من السنوات؟
كان هذا السؤال يراودني كلما التقيت انطون المقدسي المفكر العربي المعروف، والذي تربى على يديه وكتاباته عشرات من كبار الكتاب والمفكرين والمثقفين العرب، منذ ان انخرط مقدسي في الحياة العامة وفي سلك التعليم العام السوري في الاربعينات، وفي الحياة السياسية والفكرية، وصولا إلى عمله في وزارة الثقافة مديرا للتأليف والترجمة والذي تركه اخيرا إلى التقاعد بعد أن تابع لسنوات طويلة الاشراف على ترجمة واصدار عشرات الكتب المتعددة والمتنوعة الموضوعات، انتقل بعدها الى متابعة مشروعات قراءة وكتابة هادئة، تتمخض بين وقت واخر عن مقالات تنشرها صحف عربية في سياق متابعة مقدسي للشأن العام في سورية اضافة للشأن الثقافي. وسط تلك الصورة، التي يتداخل فيها التاريخ مع الحاضر، ويتمازج فيها الثقافي مع السياسي، توقفنا مع انطون المقدسي في سؤال وجواب، ذهابا في اتجاهات متعددة، يتجاور ويتداخل الخاص مع العام.
س: أين أنت من العمر ومن الاهتمامات؟
– تجاوزت الثمانين وفكرة الموت في ذهني، كما بالأمس القريب والبعيد، مجرد فكرة لا تبعث فيّ أي انفعال، مع أنني فقدت أشخاصا عزيزين عليَّ جدا، منهم والدي الذي شكلت وفاته بالنسبة لي منعطفا في حياتي، هذا شيء وموتي أنا شيء آخر. إذ ان الذي يعنيني بالدرجة الأولى، منذ أن وعيت العالم وحتى اليوم، هو مشاريعي. ومشاريعي تكاد تكون ثقافية كلها، الثقافة هي التي حولتني الى السياسة، والسياسة أعادتني الى الثقافة ذات يوم.
كان مشروع حياتي الأول، أن أتجاوز بسرعة الوضع المادي المتردي الذي كنا فيه. لسنا وحدنا، بل العموم في مدينة صغيرة مثل يبرود «مدينة صغيرة، تقع شمال دمشق بـ 65 كم)، حيث ولدت. فالدباغة وتجارة الجلود وحرفة الشعر، وتجارة منسوجاته مع البدو – الحرفتان اللتان مارسهما والدي – كانتا بالكاد تكفيان لتأمين أساسيات الحياة. في حين أن الوظيفة كانت تبدو للفقراء وكأنها ثروة كبيرة جدا. الوظيفة بحاجة الى شهادة. إذن هدفي الأول كان الحصول على شهادة الثانوية بقسميها «الأدب والفلسفة» ولم يكن ذلك بالأمر السهل. أما الإجازة «ولم يكن بالإمكان الحصول على الإجازة في الفلسفة أو الأدب إلا في فرنسا» فتبدو وكأنها تفتح أبواب الجنة.
بين الحربين العالميتين، لم يتجاوز عدد الحاصلين على الثانوية في يبرود أكثر من عشرة على ما أتذكر، وكان جلهم من أسر ثرية نسبيا، أهلهم ملاكون وزعماء. مشروع البكالوريا أستأثر بادىء ذي بدء بانتباهي كله. الثورة السورية العام 1925، هي التي نبهتني إلى أن في هذا العالم الذي أعيشه أشياء أخرى غير الشهادة.
س: أشرت الى الثورة السورية باعتبارها ذات تأثير في تفكيرك. هل نتوقف عند تلك المحطة؟
– بدت لي الثورة السورية في البداية، وكأنها احتلال رعيان وفلاحي القرى المجاورة ليبرود التي كانت عاصمتهم الاقتصادية. احتلوها بالسلاح وفرضوا على الآهلين إتاوات لا يقبلونها إلا إذا كانت عدّا ونقدا وباليرات الذهبية فقط. وكانوا يضربون، ويهينون البشر، ليثأروا لأنفسهم من تجار يبرود الذين كانوا يحتقرونهم. وكنت آنذاك وحيدا لأهلي، فخشوا عليّ وقرروا إرسالي الى رأس بعلبك في البقاع، حيث كان لنا أصدقاء أقرب من الأقرباء، يتعامل معهم أبي تجاريا. كان السفر في الليل في قافلة كبيرة على ظهور الحمير والوصول في وجه الفجر. لم تكن رأس بعلبك أحسن حالا من يبرود، فالصراع مستمر بين أهل بعلبك وآل دندش، وكان صراعا عنيفا والطلقات النارية، تمنعنا من النوم. ومع ذلك كنت حملت معي كتبي وبينها من كتب المطالعة الألياذة وأحدب نوتردام بالفرنسية وغيرها. اكتشفت تدريجيا، من الصحف القليلة التي كانت تقع بيدي، ومن أقوال بعض التجار الذين كانوا يذهبون من يبرود الى دمشق عن طريق حمص – بعلبك ومن اتصالاتي بشخصيات لها بعض الأطلاع على مجرى الأمور، اكتشفت أن الثورة السورية غير ما رأيت، على أرض الواقع في يبرود، ورأس بعلبك. فالدكتور عبدالرحمن الشهبندر وسلطان الأطرش وغيرهما من رجالات الثورة أبطال هدفهم تحرير سورية واستقلالها. لم اتمكن آنذاك من الاحاطة بكل تعقيدات الوضع، ولكن شعرت بها، لا بل عشتها. وساعدتني على التأمل بها، قراءاتي المتواصلة في الأدب أولا، ومن ثم في الفلسفة وعلمي الاجتماع والأخلاق.
هذه القراءات جعلتني أعتقد، من جهة، أن وضعي ووضع أسرتي مرتبط بوضع عام ومن جهة أخرى، ان الامور يمكن أن تكون افضل مما هي عليه، شعور غامض صار لايفارقني، ولكن لم يكن لدي أية وسيلة لجعله واضحا. فالصحف نادرة جدا، والأخبار ماهي إلا إشاعات متنافضة، والاتصال بشخصيات حكومية أوسياسية غير ممكن بالنسبة لمراهق مثلي، ومع ذلك فقد صار الحديث السياسي شيئا مهما بالنسبة لي. والحدث الثاني الذي هزني وفتح وعيي كان وفاة فوزي الغزي المأسوية، ثم قصة الدستور السوري، والأهمية الحاسمة التي للدساتير في حياة الأمم. الحدث الثالث كان اكتشاف المخابرات الفرنسية للحزب السوري القومي العام 1935 وصراعات السلطة المنتدبة إياها مع الحزب الشيوعي.
س: عاصرت مرحلة مابعد الثورة، وكنت متابعا في فترة ما قبل الاستقلال، ماهي الظواهرالمهمة التي لاحظتها؟
– ثلاث ظواهر مهمة، تعاقبت في ثلاثينات القرن العشرين على سورية، وبصورة خاصة على دمشق، كانت صلتي بها وثيقة. وأرى الآن بعد مرور زمن طويل، أنها مهدت لظواهر أخرى، ظهرت أثناء الحرب العالمية الثانية، وشكلت معها منعطفا مهما في تاريخ سورية، وربما في تاريخ المنطقة كلها.
أولى هذه الظواهر هي إضرابات 1936 التي شملت المدن السورية، وشلت الحركة فيها. كانت هذه الإضرابات بمثابة تلخيص للثورات التي تعاقبت على سورية منذ ثورة صالح العلي والثورة الكبرى وغيرها. وكرد فعل على محاولة إخضاع الفرنسيين سورية بالقوة، بتعليق الدستور ووضع جماعاتهم في المراكز الحساسة. كنت يومها في لبنان وبالضبط في زحلة، واستثارتني هذه الاضرابات التي وصل صداها إلينا مع أهم وقائعها عن طريق الصحف والمسافرين، وأذكر أنني استدنت ثماني ليرات سورية، وانتقلت الى دمشق كي أرى، واشترك في الحوادث، وقضيت فيها أسبوعا أشارك في التظاهرات، وأتحدث الى المتظاهرين والى بعض القبضايات الذين أعرفهم من يبرود، ومعلوم أن الاضرابات انتهت باتفاق بين الكتلة الوطنية وفرنسا التي كانت تقودها حكومة «ليون بلوم» الاشتراكية على صيغة، هي في الواقع، ترسيخ للانتداب ومنحه شكلا شرعيا مع استقلال شكلي لسورية، اتفاق أقرته الحكومة السورية، ولكن البرلمان الفرنسي لم يصدق عليه، وذهبت تحركات جميل مردم المكوكية جزافا. وعندما بدأت رياح الحرب الثانية تهب أوقفت الحكومة الفرنسية النشاطات السياسية كلها، وأرسلت الى سورية جيشا كبيرا، وهو المعروف باسم «جيش الشرق».
الظاهرة الثانية، هي وصول زكي الأرسوزي وتلامذته ربيع 1938 الى دمشق. كان الأرسوزي يومها ممتلئا حماسة، ويعتقد أنه سيعيد تجربة اللواء على شكل أوسع، بحيث تمهد لوحدة عربية هدفها في نقطة المحور، ويثأر لنفسه من خسارة لواء اسكندرون كما هو معلوم. والواقع أن الأرسوزي وفور وصوله، بدأ يعقد اجتماعاته، أو بالأحرى، بدأ المثقفون السوريون القوميون، حوله أينما وحيثما وجد في حلقات تستمر طوال النهار والسهرة، وكان يؤثر المقاهي على أي مكان آخر. رفاقي من يبرود أخذوني معهم الى لقائهم معه في حديقة العائلات في منطقة القصاع التي زالت من الوجود اليوم. استمعت إليه وأعجبت به مع بعض التحفظ على فلسفته، كانت ثمة أربع مفردات لها رنين خاص في حساسية الشباب في فترة ما بين الحربين: الإحياء – النهضة – البعث – اليقظة، والأرسوزي رجح عضويا كلمة «بعث» وبعدها صار مفهوم البعث على كل الألسن بين الشباب المسيسين، وجل الشباب السوري كان آخذ بالتسييس. الكلمة بذاتها غامضة، تطرح أكثر من سؤال. البعث، ان تبعث الأمة العربية. ولكن ماهي هذه الأمة؟ متى وجدت؟ وكيف ستوجد؟…
الظاهرة الثالثة، هي التعليم الثانوي السوري، لأنه كون الفئة المثقفة في سورية. وهذه الفئة كانت بمثابة انقلاب اجتماعي. وقد تضافرت جهود بعض الشخصيات الفرنسية من مستوى ثقافي متميز وعلى درجة كبيرة من الإخلاص للثقافة الفرنسية مع نخبة المثقفين العرب، الذين كانت تعنيهم اللغة العربية، منهم البزم والزركلي وخليل مردم وغيرهم، فأنشأوا تعليما ثانويا، يعطي الأدب العربي والثقافة العربية مكانة متميزة الى جانب العلوم والأدب الفرنسي. هذا التعليم الثانوي كانت شهادته «البكالوريا بقسميها» تكاد تضاهي الشهادة الفرنسية. في هذه الفترة بالذات أنشأت نخبة من العلماء العرب، على رأسهم محمد كردعلي مجمع اللغة العربية والذي مازال قائما حتى اليوم، وقد أسهم المجمع في بعث التراث العربي واللغة العربية، والذي يعنيني بالدرجة الأولى هنا هو التعليم الثانوي، لأنه كوّن مع توالي الزمن نخبة ثقافية، هي التي كونت أو أسهمت في تكوين الأحزاب السياسية.
س: اشتغلت بالتعليم بداية الأربعينات. كيف نظرت الى العملية التربوية وتحولاتها قبل الاستقلال وبعده؟
– عينت مدرسا للفلسفة أولا في حمص ومن ثم في حماة، وبعدئذ في حلب، وبعدها صرت مدرسا بدمشق في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1940، حاولت أول ما حاولت أن أعرف الانتماء الطبقي للطلاب. جلهم كانوا في المدن من الطبقات المتوسطة «حلاق – صاحب حانوت – حرفي…» الفقراء قلة، وأبناء الأثرياء أقل أيضا. ومع الزمن وبعد الاستقلال ازداد عدد الطلاب بشكل ملحوظ، التعليم في عهد فرنسا كان نخبوياً كما في فرنسا ذاتها، أما في عهد الاستقلال فالأحزاب وعلى رأسها حزب البعث، حرّضت الشعب على الدخول في المدارس، فصار عدد الطلاب يزيد بشكل مضطرد عاما إثر عام. وصار انتماء الغالبية الساحقة من الطلاب إلى الطبقات الفقيرة والمعدمة أحيانا.
العام 1949، أنشأ ساطع الحصري الجامعة لم يكن قبله في سورية سوى كلية للطب وفروعه، وكلية للحقوق، فصارت مع الحصري جامعة في غالبية شهاداتها الأدبية والعلمية، وتديرها هيئة شبه مستقلة، اثناء تدريسي للفلسفة في الجامعة السورية كمحاضر، تابعت استقصائي لمنبت الطلاب الطبقي، وما أدهشني أن أولاد الفلاحين من القرى النائية، وأولاد الرعيان، صاروا يحصلون على الإجازة في الطب أو في الأدب وغير ذلك من الفروع. هذا في نظري شكل بداية يقظة شعبية أدت تدريجيا مع مرور الزمن إلى انقلاب اجتماعي. فالذي يلاحظ بصورة خاصة رجالات الحكم، يدهشه أنهم كانوا بادئ ذي بدء من كبار مالكي الأراضي، وتدريجيا صاروا من الفئات المتوسطة فالفقيرة، كل فئة تزيح الأكثر ثراء منها وتحتل محلها، وحكامنا اليوم في سورية والهلال الخصيب كلهم من الطبقات المتوسطة فما دون. هذا الانقلاب الاجتماعي هوالذي بدل وجه سورية الاجتماعي، وقد أعقبه العام 1974 انقلاب آخر في المجتمع السوري، فقسمه الى طبقتين الواحدة غنية والثانية فقيرة، وهذا حديث آخر.
س: تميزت سورية بظاهرة الأحزاب السياسية والعقائدية منها بشكل خاص، وقد عاصرت حقبا من تأسيس الأحزاب ونشاطها. كيف نظرت إليها؟
– يعود تأسيس الأحزاب الشيوعية في المنطقة الى بعيد الحرب العالمية الأولى، ولكنها لم تتركز ويصير عملها منهجيا إلا بعيد الثلاثينات، عندما عاد خالد بكداش من الاتحاد السوفياتي، وصار أمينا عاما للحزب الشيوعي السوري، ومشرفا على الأحزاب الشيوعية في المنطقة. بدأت الأفكار اليسارية، تنتشر وتستقطب الشباب بين الحربين، فظهرت مجلات يسارية كثيرة، أكثرها شهرة مجلة «الطليعة»، التي شهدت أولى كتابات اليساريين، بينهم كان ميشيل عفلق، وناصر حده وكامل عياد… وغيرهم.
ظاهرة ثانية من ظواهر تلك المرحلة، تأسيس مكتب حزب البعث أيضا العام 1943 الذي تبنى العام 1947 دستورا، ويعلن عن ذاته.
الظاهرة الثالثة تشكيل حزب الاخوان المسلمين في الثلاثينات بمشاركة المرحومين مصطفى السباعي ومحمد مبارك.
الظاهرة الرابعة هي زكي الأرسوزي، وقد نقل نشاطه من السياسة إلى الثقافة، ونشر أول كتبه، وفيه فلسفته كلها تقريبا، وهو «عبقرية الأمة العربية في لسانها» كان الأرسوزي قبلها ناشطا بواسطة تلاميذه من أمثال صدقي إسماعيل وأدهم إسماعيل وسليمان العيسى وغيرهم في المدارس الثانوية أسوة ببقية الحركات السياسية. وكانت المدارس الثانوية في ذلك الوقت من محاور النشاط السياسي الأهم قبل تأسيس الجامعة. فإذا أضربت المدرسة الثانوية في دمشق، فقد تشل الحركة التجارية في سورية كلها، ويفهم الفرنسيون الأرسوزي بأنهم لايمكن أن يتسامحوا أثناء الحرب بأي نشاط سياسي يتم بدون إذنهم. ولم يتراجع حتى أجبروه يوما على أن يجتاز سورية من دمشق الى حلب فاللاذقية سيرا على الأقدام. وعلى كل حال، كان الارسوزي قد تخلى عن تأسيس حزب سياسي باسم البعث – مؤقتا على حد تعبيره – والمؤقت صار نهائياً، فاستأثر ميشيل عفلق بالكلمة، وأسس حزب البعث العربي.
س: نتوقف عند نظرتك إلى المثقفين وقد عاشرتهم وعرفتهم ودائما كنت في صفوفهم. كيف نلخص نظرتك اليهم؟
– الحديث طويل في هذا، وتستدعيه تأملات مثقف في ماضيه وعلاقاته، وفي الحوادث السياسية والاجتماعية والثقافية التي عاشها، وأسهم فيها، أو كان شاهدا عليها طوال حوالي ستين عاما من الزمن، وأتوقف عند ثلاث نقاط اختصارا، وهي أمور لاشك عندي فيها:
أولا: كون المثقفين، جلهم أن لم يكونوا كلهم، من الطبقات المتوسطة والفقيرة، اليوم وغدا على مايبدو كما بالأمس. ومن الملاحظ أن رجالات الحكم هم أيضا من الطبقات ذاتها.
ثانيا: أن المثقفين هم الذين أنشأوا الأحزاب، وأسسوا لإيديولوجيا كل منها، وهم أعضاؤها اليوم وغدا كما بالأمس. الشعب ملحق بهم وبالقيادات السياسية حتى ولو انتسب لهذا الحزب أو ذاك. والفعالية بيد القادة دوما.
ثالثا: أن المثقف هو الذي كان له الدور الأول في يقظة الشعب. وتنبيهه إلى حقوقه. وهذه اليقظة هي التي بدلت وأحيانا بشكل جذري الوجه الاجتماعي والسياسي والثقافي للمنطقة كلها.
فالسؤال الذي يطرح ذاته علينا اليوم هو : هل تخلى المثقف عن دوره بعد قيام حكومات عسكرية أو شبه عسكرية. أي شديدة التركيز والقوة، حيث السلطة التنفيذية تشد السلطات الأخرى إليها وكأنها تذيبها فيها. المؤكد عندي، أن المثقف فقد منذ أواخر الستينات استقلاله ومبادهته. وصار تابعا للحكم. فالدور الذي ينهض به اليوم كما بالأمس اقرب هو كتابة نصوص أدبية أو فكرية، تكشف عن ثغرات الحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والواقع أن المثقف خاف عندما وجد ذاته في أواسط الخمسينات في مواجهة العملية السياسية التي هي صراع على مصالح مادية، تشترك في عدة جهات محلية واقليمية وعالمية. وهذا الطرح يزيحك بسرعة وبعنف إذا لم تكن في موقع ومن مستوى يمكنك أن تسهم فيه، وهنا المعيار هو رصيدك المالي الاقتصادي، يليه السياسي وفي الدرجة الأخيرة الثقافي.
__________________________________
المصدر: صحيفة (الوسط) البحرينية، العدد 1 – الجمعة 06 سبتمبر 2002م




