حوار حول مسألة الهوية وإشكالاتها في العالم المعاصر بين الكاتب والباحث “ماهر مسعود” والكاتب والباحث “شريف مبروكي” متضمن أربعة مقالات
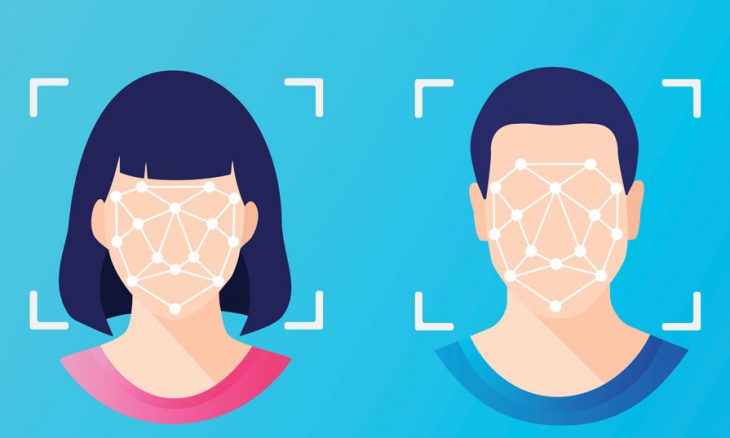
———————————-
محاورة: مأزق الهوية في العالم المعاصر/ ماهر مسعود
01 مارس 2024
(هذا النص هو الأوّل من أربعة نصوص، تشكل بمجموعها محاورة بين الكاتب والباحث ماهر مسعود والكاتب والمترجم شريف مبروكي، وتتمحور حول مسألة الهوية وإشكالاتها في العالم المعاصر).
تخلق الحياة المعاصرة بتعقيدها التكنولوجي وسرعة تغيّراتها وكثافة ضغوطها المعولمة أزمة هوية عميقة ومركّبة بالمعنى الوجودي للأفراد في كلّ مكان تقريباً. لكن مأزق الهوية الفردي لا يمكن فهمه دون فهم اندراجه في نطاق أزمات أوسع تطاول البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات. فضمن أنظمة الاجتماع السياسي الراهنة باتت تتداخل أزمة ما سمّاه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو مجتمعات السيادة (كحال مجتمعاتنا)، مع أزمة مجتمعات الانضباط (الصين نموذجاً)، مع أزمة ما أطلق عليه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز مجتمعات التحكّم في الفضاء المفتوح (كما هو الأمر في الديمقراطيات الغربية). وبفعل سيطرة التكنولوجيا والتواصل الرقمي على مستوى العالم، بتنا نعيش في ما يعتبره الفيلسوف الألماني/الكوري الجنوبي المعاصر بيونغ شول هان سجناً عالمياً أو “Global Panopticon”، يكون فيه الجميع تحت المراقبة والتحكّم. فمن تفرّقهم الجغرافيا والتاريخ تجمعهم الميديا والإنترنت والحروب والإرهاب والأزمة البيئية، ومن تفصلهم حدود الواقع الفعلي تعيد وصلهم خرائط الواقع الافتراضي.
يتولى جهاز السلطة في نموذج مجتمعات السيادة مسألة تقرير الحياة والموت، ويحدّد المسموح والممنوع في سلوك أفراده، بينما يُضبط الأفراد في نموذج مجتمعات الانضباط ضمن حلقات مغلقة، مثل العائلة والمدرسة والمصنع والسجن والثكنة العسكرية. وأمّا في نموذج مجتمعات التحكّم، فتنتشر السلطة جذمورياً في أدق تفاصيل الحياة وتنقل الجميع إلى فضاءات واسعة من الاعتقال غير الفيزيائي، فينوخ الأفراد تحت حمل الضغط النفسي الهائل الذي يولّده العيش في “مجتمع الإنجاز”، حيث بات الاكتئاب هو مرض العصر، وحيث لم يعد العنف، سلبياً أو خارجياً أو موّجهاً نحو آخر نقوم بنفيه، بل بات مخفياً تحت ستار الإيجابية، وموّجهاً نحو الداخل، ومن هنا ارتباطه بالنرجسية المنتشرة مثل الوباء في مجتمعات الفرجة المعاصرة.
فضاء الممكنات الذي تتمازج فيه النماذج السابقة بعضها مع بعض يخلق وضعاً معمّماً من الغموض والالتباس، ويترك الأفراد في حالة من الضياع وغياب الاتجاهات والوجهات، فيفقد الناس أمان الانتماء الذي كانت تمنحه الهويات القديمة (سواء كانت هويات وطنية أو قومية أو دينية، حزبية أو وظيفية أو حتى جندرية)، ويغرق الأفراد في قلق التهديد الدائم الذي ينتجه التغيير السريع، وانعدام الرؤية الذي يخترق نمط الحياة المعاصرة على كلّ المستويات.
التفكير في إشكال الهوية على هذا النحو المركّب يدفعنا للتساؤل إن كان البحث عن هويات مستقرّة وثابتة هو الحل، وإن كانت العودة للروابط العائلية والعشائرية والطائفية والدينية أو القومية هي الترياق، أو إن كان الانغماس في سياسات الهوية وأشكال الجندرة و”القبليّة المعاصرة” هو ما يعيد الأمان المفقود، كما يجعلنا نفكر إن كان الرثاء لأحوالنا بعد ضياع الهويات القديمة “في الزمن الجميل”، ومن ثم الانغماس في أوجه الشكوى والعدمية هو الموقف الصحيح! هل علينا إدارة ظهرنا للعالم والالتفات لشؤوننا الخاصة و”ممارسة اليوغا” بحثاً عن خلاصٍ فرديٍّ لا يأتي، أم انتظار الخلاص الجماعي الذي وعدت بها الأديان والأيديولوجيات القديمة؟
ليست هناك إجابة أحادية وشافية لتلك الأسئلة، لكن نقاشاً نقدياً لبعض الطروحات الفلسفية المعاصرة قد يساهم في تفعيل الفكر وتوليد الحلول المبتكرة. ومن أهم تلك الطروحات ما كتبه بيونغ شول هان حول أنّ الحرية الفردية التي بُنَي عليها الأساس المتين للمجتمع الحديث تحوّلت هي ذاتها؛ تحت ضغط الرأسمالية، إلى عبودية أسوأ من جميع أشكال العبودية في التاريخ. فما ناضل الإنسان للتحرّر من عبوديته عبر التاريخ، تمثّل دائماً بآخر خارج الذات، آخر ينفيها أو يضطهدها أو يتسيّد عليها (الآخرون هم الجحيم، يقول سارتر). لكن ما بات يستعبد الذات اليوم لا يقع خارجها، بل بات مزروعاً في داخلها. أصبح كلٌ منّا مشروع نفسه التي عليه تسويقها مثل ما تُسوَّق المنتجات، كل منّا هو السيّد والعبد بالمعنى الهيغلي في الوقت ذاته. ولذلك يؤكد هان أنّ الإنسان المعاصر هو تمثيل فعلي لما يدعوه: “الهوموليبر” (Homo Liber)، ويقصد به الإنسان الحر والمُستباح في الوقت ذاته. ويجمع هان في هذا المفهوم بين الإنسان الأخير؛ الذي يظن نفسه حرّاً، عند نيتشه والإنسان المستباح “هوموساكر” (homo sacer) عند أغامبين في قالب واحد.
في كتابه “طوبولوجيا العنف”، يطرح شول هان نقداً ضمنياً لجيل دولوز الذي قدّمت فلسفته انتقالاً في صورة الفكر المعاصر من الـ”يجب عليك” (You should) إلى الـ”ربما يمكنك” (You may can)، ويعتبر هان أن تلك الـ”يمكنك” تمثّل عنف الإيجابية، وهو العنف الموّجه إلى الذات لمعاقبتها على تقصيرها ودفعها نحو الإنجاز والتراكم. التراكم الشبيه بتراكم رأس المال، الذي يصبّ في المحصلة في خدمة الرأسمالية. لكن ذلك النقد الضمني تصدر عنه مطالبة هامسة للعودة إلى النفي والسلبية، إلى الجماعية وقيم العائلة، وهي مطالبة تضعنا مباشرة في طريق مسدود، باب موصد للثنائية الديكارتية. فما يغيب عن رؤية هان يتجلّى في أنه، سواء كان الواقع الاجتماعي السياسي رأسماليا أو إقطاعيا، إيجابيا أو سلبيا، فإنّ الأقلية “القلّة” هي دائماً من يقاوم في كلّ العصور وكلّ الأزمنة، وهنا لا يعود السؤال: ما هو النظام الأكثر قسوة وما هو الأقل تسامحاً؟ لأنّه في كلّ نظام ستتواجه على نحو مستمر عناصر التحرّر مع عناصر الاستعباد. وهذا الفهم يجعلنا نرى الأمر بصورة مختلفة، فمشاكلنا الفردية والجمعية، اليوم، لا تعد كبيرة إلا بالقياس إلى من سبقونا، لكنها على قياسنا، نحن خلقناها، ونحن من علينا ابتكار الطرق الجديدة لحلّها. ليست مشكلات البيئة والجندر واليمين المتطرف والجنون التكنولوجي والحروب والثورات والإرهاب إلا مشاكل على قياسنا، ليست نهايتنا، بل تحدّياتنا التي لن ينفع معها الرثاء، ولا العودة إلى الماضي الرومانسي للنفي والهويات المغلقة. وإن كانت العولمة هي السجن العالمي، فمهمة الفلسفة؛ والفن أيضاً، هي إيجاد “خطوط الانفلات” والبحث عن الثقوب والثغرات والاختراقات، وخلق فضاء الممكنات الذي يحيلنا إلى نمطٍ جديدٍ للمقاومة وابتكار الحلول.
قد يبدو مأزق الهوية للوهلة الأولى وكأنه ماكينة لتوليد التعاسة، فيتخبّط الناس بحثاً عن ذات لا يجدونها ويملؤهم الحنين إلى فردوس طفلي ضائع. تصبح الهوية تمثيلاً للكمال المنشود وفقدانها نقصاً جوهرياً في الحياة، وفي معنى الحياة. وتزيد التعاسة عندما تنهكنا الخيارات المتعدّدة، فنعمل وكأنّنا بلا خيار، وتصبح حريتنا هي مشكلتنا بعد أن كانت خلاصنا وكانت وجهتنا. ولكن عندما نفكر عميقاً في ذلك كلّه، سنجد أنّنا لم نعد نعرف الوجهة بالضبط نتيجة احتكامنا لفكرة النقص، نريد أن نأخذ الخيار الأمثل الذي يملأ فراغنا ونقصنا الوجودي دون أن نعلم أنّ ذلك النقص هو بطبيعته نقص أبدي، لا يمتلئ. هذا طريق كئيب ومولّد للخيبة والتعاسة، طريق يجعلنا نقضي أعمارنا ونحن نركض خلف القمر.
عند التفكير في تعقيد العالم المعاصر، والأصوات العالية للشكوى والمخاوف والتحذيرات، ستظن مباشرة أنّ البساطة هي الحل، فتهرع مباشرة إلى أمثال جوردان بيترسون لتأخذ بعض المهدئات الإنجيلية بلا إنجيل و(أحياناً معه). لكن ما يُغفل في ذلك الهروب الكبير نحو الخلاص ونحو التهدئة هو الحقيقة القائلة إنّ المعقد هو البسيط عندما نفككه إلى عناصره الأولية، وعندما ننظر إليه من وجهة نظر محلية (على طريقة ما فعله ريمان في هندسة المكان اللاإقليدي)، أي عندما ننظر إليه من وجهة نظر الحياة في ما وراء الخير والشر، الحياة دون أحكام المتعالي أو الأحكام المسبقة لما يجب أن تكون عليه الحياة. عندها سيصبح كلّ شيء مبرّراً لأنه بالضبط لا تبرير له.
يقول بعض البيولوجيين إنّ الحياة نفسها تقوم ضد الفيزياء، لأنّ الحياة هي الحركة، والحركة تعمل ضد الميل الفيزيائي الدائم نحو السكون (الماء يتجه عفوياً نحو أدنى نقطة على سطح الأرض ليستقر). الحياة ذاتها إذاً مقاوَمة للموت، مقاوَمة للسكون. وليس بحثنا الدائب عن هوية ثابتة إلا توّجهاً لاواعياً نحو السكون والموت. وبهذا المعنى، لن يكون ضياع الهوية هو المحزن، بل إيجادها والارتكان إلى ثباتها واكتمالها وامتناع تجديدها. فلا تُعرَّف الحياة بالهوية والثبات والكينونة إلا لتفقد تعريفها في حركة الاختلاف. الحياة حركة وصيرورة لا تعرف التوقف، والحركة هي إنتاج الاختلاف وصناعة التأثير والتغيير في وجودنا ووجود من نعيش بينهم، وهذا يعني في ما يعنيه مقاومة للموت وإثباتا للحياة وحبّاً للقدر (Amor fati) كما كان يقول الرواقيون. كما أنّ الحياة لا توجد في الهويات القديمة والأصول الماضية ولا في نهاية الطريق، الحياة هي الطريق، وعلى الطريق إلى…، دون أن يكون لتلك الـ”إلى” أي خاتمة، وخصوصاً، أي خاتمة سعيدة.
تستضيف مدونة “محاورة” في كلّ شهر كاتبين أو كاتبتين يتحاوران/تتحاوران حول مسألة تهمهما، وذلك في محاولة للاحتفاء بالحوار والاختلاف والرأي الآخر.
العربي الجديدة
——————————
محاورة: الهُوية لغز أم مأزق؟/ شريف مبروكي
08 مارس 2024
(هذا النص هو الثاني من أربعة نصوص، تشكّل بمجموعها محاورة بين الكاتب والباحث ماهر مسعود والكاتب والمترجم شريف مبروكي، وتتمحور حول مسألة الهوية وإشكالاتها في العالم المعاصر. يمكن قراءة النص الأول على هذا الرابط).
سيحاول هذا المقال النظر بعجالةٍ في مشكلة الهُوية بوصفها، بادئ ذي بدء، مفهوماً فلسفياً أساسياً نشأ وتبلور منذ أن بدأ الإنسان يتأمّل الأشياء والكائنات ويتساءل عن مكانته في هذا العالم، وإن كان هذا المفهوم يفتقر في معظم المقاربات الثقافوية والسياسوية المعاصرة، التي تريد احتكاره والتلاعب به وتجييره لخدمة رؤى ومعتقداتٍ ومصالح، إلى التجذير والتمحيص والبلورة، وخصوصاً إلى التأسيس المعرفي. سأحاول هنا أن أقدّم قراءتي الشخصية لهذا الأمر، مستعيناً بقراءة بعض الفلاسفة المعاصرين، ولعلّني بذلك سأقترح رداً غير مباشر لما جاء في مقال الأستاذ ماهر مسعود المعنون “مأزق الهوية في العالم المعاصر”، حيث ربط المقال المذكور مشكلةَ الهوية بمسألة الاختلاف، أو بدقة الوعي بالاختلاف، وألحقها بثلاثةِ أنماطٍ اجتماعيةٍ سائدة هي “مجتمعات السيادة” و”مجتمعات الانضباط” و”مجتمعات التحكّم”، لينتهي إلى أنّ الهوية هي “ماكينة لتوليد التعاسة”، بحسب رأيه، وهي بحث “طفولي” عن “كمال منشود” كما لو أنّ فقدانها هو “نقص جوهري في الحياة”. ولكنّ هذا الخيار في النظر في مشكلة الهوية، وإن كان له ما يبرّره، إلا أنّه يقع في نزعةٍ اختزالية لمشكلة لا تقبل الاختزال والردّ إلى المقاربات السوسيوثقافية المهيمنة وحدها التي أوردها في مقاله، ولا في النماذج السياسية ذات الطابع النضالي التي يضمرها، فهي مشكلة متجذّرة في عمق الروح الإنساني بحسب تصوّر هيغل الذي نقل المسألة من المجال النظري المحض إلى المجال الاجتماعي والمدني والحقوقي؛ لكي تصبح الهوية اعترافًا بالآخرية، ومجموعةً متشابكة من التفاعلات والممارسات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي والتاريخي، فلا اعتراف ولا صيرورة لوعي ذاتي بدونها، ولا مجال لإقامة مملكة الحرية دون تسويغ Justification عقلاني وأنطولوجي لها.
أنا لا أعتقد أنّ الهوية في أبعادها الشخصية والثقافية والروحية والسياسية تعيش مأزقاً بالمعنى الدقيق للكلمة بل، ربّما، هي تعيش أزمة، وهذا توصيف مختلف، فالمأزق يُوحي بانتفاء الحلّ والوقوع في طريق مسدود، ولكنّني أرى، على خلاف ذلك، بأنّ الهُوية، أو الهُويات بصيغة الجمع، لا تعيش مأزقاً بالمعنيين الاصطلاحي واللغوي، ولكنها تعيش أزمة على مستويات مختلفة، ولعلها أزمة ضرورية لإعادة النظر في ذاتها، في مجراها، في صيرورتها، في حركة الاختلاف القائمة فيها، وخصوصاً في ديناميكيتها الذاتية بوصفها إمكاناً لوجودٍ – في – العالم منفتحٍ على الغيرية والصيرورة والتحوّل.
ذلك أنّ مسألة الهوية، وإن كانت في أوج ذروتها، فإنّها ربّما تعيش، على نحو متناقض، أكبر أزمة في تاريخها؛ إذ يتم إخفاء مفارقاتها البدائية، أو إحراجها المؤسّس، بمهارة داخل المجتمع الاستهلاكي المعاصر الذي، وإن كان غير مكترث في الظاهر إزاء قضايا الهوية الشائكة، ما فتئ يستثمرها، يُعيد تركيبها وتوضيعها في هشاشة نسقية فائقة وذات إيقاع متواتر وعنيف لا يؤدي إلّا إلى مزيدٍ من الضعف والتمزّق البنائي والانجراحات في الكينونة الإنسانية التي لا تستطيع العيش إلاّ في هوية ما. ومن هنا يبدو لنا الاهتمام بإعادة النظر الدائمة في هذا المفهوم أمراً جديراً بالعناية، بل ضرورياً، حتى وإن كان السؤال لن يجد، في نهاية المطاف، إجابة ثابتة ومحدودة ونهائية أبدًا تُلبي حاجته ورجاءه.
قد تكون الهوية، في أحد أبعادها الأساسية، من نفس نظام الذاكرة كما يؤكد ذلك بول ريكور؛ فهي حضورٌ للغياب، أي أنّها نسق لا يمكننا إثباته بحججٍ عقلية صارمة ونهائية ولكنّنا مع ذلك مقتنعون بحدسه بشكل وثيق وباطني. فالهوية هي، أولاً وقبل كلّ شيء، مسألة حميمية، إحساس عميق وغامض لا تتقوّم الذات الفردية والجماعية بدونه، ولا تشعر بكيانها في غيابه. فالهوية، أو الإحساس بالهوية، هي لزوم كياني، قوام ذي أساسٍ أنطولوجي يصبح الوجود بدونه رخواً، هشاً، يقيم في خواءٍ وعرضةً دائمة للفناء والاضمحلال.
فإذا أردنا أن نستنطق مشكلة الهوية وليس فقط دحض مفهومها، ونطرح على أنفسنا السؤال التالي: هل نستطيع أن نكون وتتحقّق إنسانيتنا وفرديتنا المنشودة بدون هُوية نقيم فيها ونتأسّس عليها؟ وجب علينا أولاً أن نتساءل عن دلالتها ومكوّناتها وأسسها ونماذج العلاقة التي تقيمها مع العالم، مع الآخرية، ومع الذات عينها، أي تلك المقوّمات التي تحملها وتعيّنها، والتي لا تكون الهوية ممكنة داخل ثقافة ما، أو نمطٍ اجتماعي محدَّد، أو نمط وعي ذاتي خاص بدونها. ومع ذلك، فإنّ إعادة طرح هذا السؤال بإلحاحٍ لهو أمر ضروري لأنّه يحدّد هويتنا كبشر، فهو يزوّدنا بالقدرة المذهلة على النظر التفكّري reflexive في وجودنا الذاتي، والقدرة على سرد قصة حياتنا بوصفنا كائنات موحّدة وتمتلك قواماً كيانياً خاصاً بها وديمومة في الزمان. وهو سؤال من أكثر الأسئلة عنادًا وأكثرها استغلاقاً في الفكر الفلسفي، إلى درجة أنّه يبدو كأحجية أو لغز. ومع ذلك، فإنّنا لا نتوقف أبدًا عن التساؤل عن سرّ هذا الأمر العنيد. وهذا ليس شيئاً نافلاً بالنسبة للفكر عينه لأنّ لا فكر حقيقي بدون تلمّس نظري لمسألة الهوية، فسؤال الهوية هو سؤال الفلسفة بامتياز، دعني أقول إنّه السؤال الأبستيمولوجي المركزي، فهو السؤال الذي قدّم للفكر أدوات للنظر في نفسه، في إمكانه، في شروطه الذاتية، في غاياته، في مشروعيته، في سداده، في صلاحيته لأنه يدعونا، بدءًا، إلى الارتياب في أنفسنا وعدم إضفاء البداهة على علاقتنا بذواتنا وبالآخرين وبالعالم إجمالاً، وهذا ما قد يبدو إدراكاً محايثاً لمسألة الاختلاف ضمن الهوية التي ستطرحها الفلسفة المعاصرة بوصفها منعرجاً، والتي يصل إليها الأستاذ ماهر مسعود بقفزة نظرية من المقدمة إلى النتيجة.
فالسؤال عن الهوية من هذا الوجه هو السؤال الملح عن هذا الكائن الواعي المتأمل في ذاته، وفي مقامه في العالم، وطرحه غير المسبوق على نفسه “من أنا؟” وهو سؤال حاسم ومفتوح على كلّ الأجوبة، وعلى كلّ المقاربات. فسؤال الهوية يكمن في قلب اللغز الذي يمثله لنا لأنّه لن يكون بإمكاننا إدراك أنفسنا على الكلية والجملة والتدقيق مرّة واحدة، وفي صورة إجمالية واحدة. ويبدو الفضول لمعرفة النفس بنفسها أيّ بإدراكها لهويتها، وهو السؤال السقراطي المركزي والمؤسّس، قد جُوبه بعوائق جمّة داخلية وخارجية أدّت جميعها إلى تعميق اللغز وسوء الفهم حول هذا الأمر المحيّر الذي يبدو من الصعب جدًا التغلب عليه.
ولعل لغز الهُوية هذا يجعل من الممكن التأكيد على أنّ الإنسان كائن حرّ من حيث الإمكان ولا يمكن إعاقة حريته، إلا بإعاقة هويته، أو تحديدها من الخارج بشكل تعسفي، أو إعادة إنتاجها وفق صور نمطية مُعطاة وموّزعة بحسب مصالح خارجية وفي خدمة قوى هيمنة. ولذلك فإنّ لمسألة الهوية تأثيرات أخلاقية وسياسية حاسمة على الدوام، فالصراع العالمي القديم والراهن ينتهي دوماً إلى صراع هوياتي، يخفي، بطبيعة الحال، صراع مصالح ونفوذ هيمنة، ولكن يبقى السؤال الملحّ هو: من يهيمن على من؟ وهو سؤال الهوية نفسها.
إنّ الاهتمام المُستعاد بمسألة الهوية، من الناحية النظرية، ليس وليد اليوم وليس أيضاً إنتاج إيديولوجي للحقبة ما بعد الكولونيالية كما تعلن الدراسات الثقافوية؛ فقد سيطر هذا السؤال على التقليد الفلسفي منذ ولادته. لقد وضع فلاسفة ما قبل سقراط، مثل بارمينيدس وهيراقليطس، هذا المفهوم في مركز تفكيرهم، فالأول ربطه بثبات الكينونة وتماهيها مع ذاتها والثاني ربطه بالصيرورة والتحوّل. ولكنّ التجريبيين، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانوا أول من استعاد مصطلح الهوية بوصفه تعييناً للشخصية الاعتبارية والسياسية والذاتية، وللكائن البشري عموماً وربطه بشروط الحرية والمسؤولية. وقد كان جون لوك، على وجه الخصوص، أوّل من واجه مسألة الهوية وعلاقتها بالزمان، وربطها بالذاكرة وبالوعي الذاتي وجعلها قائمةً في وعي الأفعال التي يقوم بها المرء وفقاً لحريته السياسية والأخلاقية. ولكن يعود إلى مارتن هايدغر إعادة طرح السؤال بشكل فلسفي جذري فيما يسمّى باللغة الألمانية die Werfrage، أي بعبارة أخرى السؤال عن: من؟ في “المشكلات الأساسية للفينومينولوجيا”، وهي مجموعة من المحاضرات ألقيت في جامعة ماربورغ سنة 1927، حيث يميّز هايدغر بين السؤال عن: ما هو؟ بم يتعلق الأمر؟ باللاتينية: quid est؟ والسؤال عن: من هو؟ من هو الدازاين، أي الكائن المتعيّن الذي هو نحن، أنا، أنت؟ يكتب هايدغر: “إنّه (أي السؤال من؟) ليس سؤالَ ماهيةٍ، ولكن، إذا جازت صياغة مثل هذا المصطلح، فإنّ هذا ال من، هو الوجود عينه الذي ينتمي إلى تقوّم الدازاين. فالجواب على السؤال: من؟ لا يحيل إلى كينونة عامة، بل إلى أنا، أنت، نحن”. وغني عن القول إنّ التمييز بين السؤال عمّا الشيء وعمّن الكائن الذي يعي ذاته بوصفه ليس شيئاً هو تمييز أساسي ولكنّه موجود قبل هايدغر بكثير، فهو تمييز يعرفه الجميع، في أعماقهم، إذ إنّه موجود في قلب اللغة التي يتكلمونها وإن كانوا لا يدركونها نظرياً. وكلّ مشروع هايدغر في كتابه العمدة “الكينونة والزمان” إنّما هو، باختصار، بحث فينومينولوجي في مسألة الهوية التي لا تقيّم في أيّ موضوع كان ولكن لا يقوم الفكر بدونها. ودون الخوض في تعقيدات المتن الهايدغري ومدونته الاصطلاحية فإّن الدزاين، أي الكائن في عيانيته اليومية، الذي هو نحن أنفسنا، لا يتعيّن إلا في هوية ما، وإن كانت هذه الأخيرة تتأسّس على الاختلاف الدائم داخلها وبين جميع مكوّناتها، وفي حركة الاختلاف التي تميّزها عن الأشياء وعن الأدوات وعن كلّ أشكال الاستعمال البراغماتي. فالهوية هي أفق وجود الوعي بالكينونة على الأصالة. ويمكنني القول إنّ سؤال الهوية قد سيطر على معظم الفكر الفلسفي في القرن العشرين، إذ ارتبط بمسألة الذاتية والفردية وبمسألتي الوعي واللاوعي، والأنا والغير، وبالأخلاق والحرية وبمشكلة الوجود نفسه.
وقد قدم الفيلسوف الفرنسي بول ريكور إضافة أخرى حاسمة في رأيي، في ما يتعلّق بمقاربة هذه الإشكالية من الناحية الفلسفية وبقي يعود إليها في معظم أعماله. فقد طرح في كتابه “الزمان والسرد”، خصوصاً في الجزء الثالث، مفهوم الهوية السردية وهو مفهوم يجد مصدره في نقد هيوم ونيتشه للأنا باعتبارها ذاتًا متطابقة مع نفسها، وهي ثمرة الوهم الجوهراني الذي ساد الفلسفة منذ أرسطو، وهو نقدٌ يؤيده ريكور جزئيًا. ولكنّه في الواقع، مع الاعتراف بأهمية هذا النقد ومع نبذ مفردات الأنانوية L’egologie، يظل ريكور مهتماً بالحفاظ على هوية الشخص وتعريفه لذاته، وذلك في مثال بارز حين يسأل يسوع المسيح تلاميذه: “مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟” وهو سؤال يربط الهوية بالإنية وبالقصة الشخصية للفرد وعلاقته بأسلافه وسلالته ولغته وأرضه ومعتقده وما إلى ذلك. كما أنّه يعارض المفهوم الهووي للهويةidentité-idem التي تتجاهل التغيير وتنحو إلى الانغلاق، بهوية الذات، أو الإنية identité-ipse التي تنطوي على طفرة في تماسك الحياة وتكاملها وتجعل الشخص فرداً بعينه في انفتاحه على الغيرية وعلى العالم. فمفهوم الهوية السردية يتعلّق في المقام الأول بالفرد والطريقة التي يفهم بها نفسه انطلاقاً من قصة وجوده التي ينسجها خياله السردي، ممّا يجعل قصة الحياة الفردية حكاية أو “قصة خيالية”. وبالتأكيد، فقصة الحياة تتقوّم هنا على الإجابة عن سؤال: “من”؟ من فعل هذا؟ من هو المسؤول عن هذا الفعل أو ذاك؟ من يريد؟ فعند ريكور ترتبط مشكلة الهوية بمشكلة الإرادة وبمشكلة المسؤولية وبالنهاية بمشكلة الحرية نفسها.
وبالعودة إلى جوانب فلسفية أوسع لنختتم المسألة، يمكننا تعريف الهوية في هذا الإطار بأنها “حقيقة الوجود الشخصي عينه”، أي العلاقة التي تربط كلّ فرد بنفسه، والتي تجعله يشعر بأنّه هو نفسه عينه. وبالتالي، سيكون الأمر متعلّقاً بالتمثّل الذي لدى المرء عن نفسه، والمرتبط بالشعور بالاستمرارية والديمومة والوحدة. فكلّ إنسان، في مرحلة ما من حياته، يتساءل عن هويته الفردية (ما الذي يجعله فريداً على هذا النحو أو ذاك) وعن هويته الجماعية (الانتماء إلى مجموعة، إلى عرق، إلى ثقافة). ويغطي عدّة أشكال وأنماط وجودية: جندرية ودينية وثقافية وبيولوجية، وما إلى ذلك. وهذه الاعتبارات ذات طبيعة عامة ومنطقية بآن. إنّ إحدى المهام الأساسية للفلسفة هي النظر الدائم والمرتاب في مشكلة الهوية بشكل عام، وهوية الأشياء التي يتكوّن منها العالم الذي نعيش فيه بشكل خاص، بما أنّنا نحن أنفسنا كائنات في هذا العالم الواقعي. وإذا كان الأستاذ ماهر مسعود قد ختم مقاله بنقد الهُويات القديمة والأصولية فذلك لا يمسّ من الهُوية، من حيث هي كذلك، في شيء، فهناك فرق بين التصوّرات الهووية، أي تلك الإيديولوجيات عن الهوية التي تأبى التغيير والانفتاح والصيرورة وبين الهُوية نفسها. وإذا كانت الحياة حركةً وصيرورة وصناعة اختلاف، وهذا قول صحيح، ولكن حركة وصيرورة واختلاف من إزاء من أو إزاء ماذا؟
تستضيف مدونة “محاورة” في كلّ شهر كاتبين أو كاتبتين يتحاوران/تتحاوران حول مسألة تهمهما، وذلك في محاولة للاحتفاء بالحوار والاختلاف والرأي الآخر.
———————–
محاورة: عن اختراق الهوية بالاختلاف/ ماهر مسعود
15 مارس 2024
(هذا النص هو الثالث من أربعة نصوص، تشكّل بمجموعها محاورة بين الكاتب والباحث ماهر مسعود والكاتب والمترجم شريف مبروكي، وتتمحور حول مسألة الهوية وإشكالاتها في العالم المعاصر. يمكن قراءة النص الأول على هذا الرابط، والثاني على هذا الرابط).
على الرغم من اللغة الفلسفية العالية لمقال الأستاذ شريف مبروكي، إلا أنّ الأفكار المطروحة فيه والمعاني التي أراد الدفاع عنها لم تكن فلسفية بما فيه الكفاية. فابتداء من الفكرة الأساسية للمقال، وهي اعتبار الهوية تعيش أزمة (وحتعدّي)، وليست في مأزق عميق، ذلك أنّ المأزق “يوحي بانتفاء الحل والوقوع في طريق مسدود”، سنلاحظ مباشرة كلاسيكية هذا التقويم أو الحكم الفلسفي. فالهوية ضمن هذا الطرح ستبقى بخيرٍ مفهوماً متعالياً ولا حاجة إلى القلق بشأنها، لأنّ ما تمرّ به هو مجرّد أزمةٍ عابرة و”ضرورية لإعادة النظر في ذاتها، في مجراها، وفي صيرورتها..”، لكن تلك الأزمة لن تؤثر على جوهرها، ولن تحوّلها إلى صدعٍ وجودي يخترق الوجود ذاته للكيانات الفردية والجماعية، بل ستُصيب أعراضها الزائلة بطبيعتها فقط، مثلما هو حال الأعراض دائماً في ما يخص الجواهر الأصلية.
مفهوم الهوية في طرح مبروكي إذاً أفلاطوني بالكامل؛ ومن هنا كلاسيكيته، فمِثل مُثُل أفلاطون التي لا يصيبها أيّ خللٍ مهما تعدّدت نُسخها، ومهما لاقته تلك النسخ من “أزمات” وأمراض وموت، كذلك مفهوم الهوية كما يعالجه الكاتب، فالأزمة تصيب النسخ “السوسيوثقافية” للهُويات المعاصرة، لكنها لن تصيب الأصل ولن تضعه في “مأزق” يطاول الجوهر المتعالي للهُوية. ولذلك لم يكن غريباً أن يستخدم مبروكي؛ مُدعّماً بهايدغر، كلمة “اللغز” في وصف الهُوية، فأفلاطون ذاته لطالما استعان بالأسطورة عندما أراد تفسير نظرية المُثل وتبريرها. وتلك الأسطرة و”التلغيز” لها مهمة أساسية في الفكر المجرّد من جهة، وفي الفعل السياسي من جهة أخرى، يمكن وصفها بالنزعة “المثالية” على مستوى الفكر والنزعة “المحافِظة” على المستوى السياسي والثقافي. كما أنّ من مفارقات تلك النزعة، أنّها تستند أصلاً إلى الحسّ العام والمشترك في قولها الفلسفي: “هل نستطيع أن نكون وتتحقق إنسانيتنا وفرديتنا المنشودة بدون هوية نقيم فيها ونتأسس عليها؟” أو “من منّا لا يشعر بأنّ لديه هوية مستمرة عبر ديمومة الزمان؟”، لكي تبني موقفاً متعالياً للفكر ينكر أول ما ينكر الحس العام ذاته الذي تمّ الاستناد إليه. فالهوية بحسب هذا الرأي ستبقى لغزاً أنطولوجياً للعقل الخالص لن يتمكّن من فهمه العوام والناس العاديين على رغم شعورهم بحضوره، ولذلك عليهم التعامل معه مثل لغزٍ إلهي حاضر رغم غيابه؛ ومن هنا احتفال مبروكي بتعبير بول ريكور في وصف الهوية بأنها “حضورٌ للغياب”. (فكّر في تشابه هذا الطرح أو تلاقيه في العموم مع الصيغة التي تقوم عليها كلّ الديكتاتوريات، فلا تقوم الديكتاتورية ولا يخاطب الطُغاة في كلّ مكان إلا الحس العام و”روح الشعب” والهويات الجمعية لدى الناس والحشود، أولئك الناس الذين أوّل ما تقوم به أي ديكتاتورية هو تهميشهم والتعالي عليهم وعدم الاعتراف بأهليتهم لفهم السلطة أو لحكم أنفسهم). ومن هنا مصدر الروح المحافِظة لتلك النزعة الفكرية على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي. هل يمكننا القول إنّ “لغز” الهوية هو ما أوصل هايدغر نفسه (وبقفزة واحدة للدازاين) إلى حضن النازية؟
لا ينكر مبروكي مفهوم الاختلاف بل يتبناه بقوّة، لكنه يختم بذلك السؤال الاستنكاري الذي يحطّم دفعة واحدة روح السؤال وقوّته من الداخل، ويجعل الإجابة عنه بلا معنى؛ كونها مُتضمّنة أصلاً في السؤال ذاته، فيقول: “إذا كانت الحياة حركةً وصيرورة وصناعة اختلاف، وهذا قول صحيح، ولكن حركة وصيرورة واختلاف من إزاء من أو إزاء ماذا؟”. والجواب المضمر الذي لا مهرب منه سيكون: إنها بالتأكيد حركة الهُويات الثابتة بإزاء بعضها واختلافها، وهل تركت لنا مجالاً لقول شيء مختلف؟ وهنا لا بد من توضيح مسألة في غاية الأهمية والالتباس في وقتٍ واحد، وهي أنّ الاختلاف المطروح على النحو الذي قدّمه مبروكي ليس اختلافاً في الحقيقة، بل مجرّد نقص في الهوية، نقص في التشابه (كان أرسطو يسميه nuisance، أي إزعاج) فالهُوية ضمن هذا المنطق هي الأصل، وهي ما يعود؛ أو يُعاد، إليه ذلك النوع من الاختلاف لكي يكمل نقصه بأن يصبح هوية مكتملة، ثم إذا كنّا مختلفين كلٌّ منّا بإزاء الآخر فذلك يعتمد على أنّنا في الأصل نملك هوية، متشابهين، واختلافنا هو نقصنا الذي تكمله الهوية.
لكن جواباً لا تقليدياً؛ بالأحرى لا إقليدياً، على ذلك السؤال سيكون كما يلي: إنّها حركة الأشياء وصيرورتها واختلافها بإزاء نفسها في الدرجة الأولى قبل أن يكون بعضها بإزاء بعض، فالاختلاف ضارب في أعماق كلّ هوية من داخلها وبإزاء نفسها بالمعنيين الواقعي والفعلي وليس بالمعنى الرمزي فقط. وبكلام آخر، الهوية ليست أصلاً لشيء، بل تتشكّل وتصبح هُوية بفعل التجميد، لا بفعل التجريد. نحن من يقوم بتجميد الحركة السائلة أو الصيرورة المتدفقة للكلمات والأشياء وإعطائها هوية لأجل الدراسة ولأسبابٍ عملية، وهذا شيء مشروع تماماً وضروري ولا خلاف عليه، لكن جميعنا يعلم أننا نحن والأشياء والكلمات في حركة مستمرة وتغيّر لا يمكن إيقافه ما دمنا موجودين في ديمومة الزمان. “كل شيء هو كثرة multiplicity” يقول جيل دولوز في كتابه العمدة “الاختلاف والتكرار”. فمثلاً عندما نعطي هوية للرقم واحد فنحن نجمد هذا الرقم ثم نجرده لأغراض عملية، لكن جميعنا يعلم أنه يمكن تقسيم هذا الرقم إلى عددٍ لانهائي من الأرقام الكسرية. وعندما نقول إنّ لفلانٍ من الناس هُوية عربية على سبيل المثال، فنحن نتكلم في العمق عن تركيب وليس عن واحدية. فهل هذا الشخص عربي المولد أم اللغة أم القومية أم الدين أم الولاء أم الجينات؟ وإلى أيّ حدٍّ هويته “هوياته” متناقضة أو متوائمة، وأيّ منها هويته “الأصلية”؟
غالباً ما يتمّ الاعتراض على الصيغة المطروحة أعلاه بطريقة باتت معروفة ومُستخدمة في كلّ مكان تقريباً، وتنبني تلك الطريقة على الرعب من النسبية ورفع بطاقة النسبوية في وجوهنا. ولسان حالها ينطق “عن الهوى” كما يلي: إذا كانت الهويات مُخترقة بالاختلاف من الداخل والخارج، وكلّ شيء مختلف عن كلّ شيء، ألا يوقعنا ذلك في عدميّة النسبية الكاملة ويدفعنا نحو تعليق الحكم؟ ومثل هذا الخوف “المبرّر” هو غالباً ما دفع مُفكراً بحجم إلياس مرقص إلى أن يفعل مثل كانط ويحتمي بالمطلق ملجأً من النسبي لينتهي إلى القول: “من ليس لديه مُطلق يحوّل نسبيّه إلى مطلق، وذلكم هو الاستبداد”، وبحسب هذا المنطق إذاً، لا منابة عن العودة إلى المطلق ووضعه أساساً للفكر. ينسى عشّاق المطلق وأتباع مرقص أنّ هذا الكلام؛ وعلى الرغم من أنه كلام بليغ وطنّان، لكنه فارغ، لأنه يضعنا في دورة تبدأ بالمطلق وتنتهي إليه، تماماً مثلما كانت حال الروح المطلق عند هيغل والتي تبدأ بذاتها، ومن ثم تتدحرج فوق جدل السلب في التاريخ، ثم تعود إلى ذاتها في نهاية التاريخ.
ما لا تدركه تلك المخاوف الفلسفية؛ والشعبية أيضاً، هو أنّ الاختلاف لا يعني نسبية الحقيقة بالضرورة، بل حقيقة النسبي. وهذان أمران مختلفان تماماً، فالنسبي حقيقي حتى لو لم تكن الحقيقة نسبية. قد نتفق على حقيقة معينة ثم نجمدها ونضعها في قانون علمي أو دستور مكتوب على سبيل المثال، لكن علينا أن ندرك أنّ ذلك مجرّد اتفاق عملي وليس حقيقة مطلقة. فالنسبي حقيقي وواقعي، لكنه ليس الحقيقة بألف التعريف ولامِه. علينا التخلص من مطلقات الفكر إذا أردنا الانفتاح على ممكنات الواقع وحقائقه وتعدّداته. هل بقي مكان أو أهمية للمطلق بعد نسبية آينشتاين أو ثبات دائم للهويات بعد تطوّرية داروين؟
يمكننا وضع مُحدّدين تجريبيين للهوية هما: الانبثاق والتجميد. ويشكلان معاً أساساً محايثاً ينسف كلّ أشكال التجريد والتعالي الضاربة في ثقافة الهوية. ولكي نوضّح ما نقوله نضرب مثالاً فيزيائياً: تتشكل “هُوية” جزيء الماء H2O من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، وهذا يعني أولاً، تنبثق هوية الماء انبثاقاً emergence من اتحاد عنصرين مختلفين تماماً، وتشكّل بذاتها عنصراً جديداً لا يوجد في أي منهما وحده ولا بشكل سابق على اندماجهما. ثانياً، للعناصر التي تشكّل الماء خواصُّ مناقضة تماماً لهُوية الماء المتشكلة، فالأكسجين؛ مثل الهيدروجين، يساعد على الاشتعال ويلهب النار، في حين يفعل الماء العكس، أي يطفئ النار. ثالثاً، عند اللحظة الحرجة (الدرجة مئة) تتحوّل هُوية الماء نوعياً لتصبح بخاراً، وفي لحظة أخرى (الدرجة صفر) تتحوّل إلى هُوية جديدة هي الجليد. إذاً، تنبثق هُوية الماء الفعلي والواقعي انبثاقاً ولها تاريخ ولادة وتاريخ موت، وهي تتحوّل إلى هوية جديدة بالمطلق ومختلفة نوعياً نتيجة ظروف موضوعية (درجة الحرارة)، كما أنّ الثبات الذي تأخذه في مرحلة معينة (جليد، سائل، بخار) هو تجميد يحصل طبيعياً أو اصطناعياً وليس تجريداً يحصل داخل العقل الخالص.
الآن، إذا طبّقنا ما قلناه عن الماء على هُوية الأفراد أو المجتمعات، فسنلاحظ أنّ رفع درجة حرارة المجتمعات (عبر الظلم والاضطهاد مثلاً) قد يؤدي إلى انفجارها وتغيّر هويتها بالكامل بحيث لا تعود قادرة على العيش في الهُوية القديمة حتى لو أرادت. كما أنّ تثبيت الهوية وامتناع الاختلاف؛ أو منعه، في مجتمع معيّن سيؤدي إلى جمود فكري وإنساني في ذلك المجتمع، أو تصحّر “جليدي” فيه يحرمه التطوّر والنمو ويشلّه بالتكرار. أمّا على المستوى الفردي، فيكفي بالمناسبة أن ترتفع درجة حرارة الجسم فوق الأربعين حتى يدخل المرء في الهذيان ويفقد هويته المعتادة والواعية والمستخدمة في الحياة اليومية. كما قد تؤدي زيادة الضغط النفسي والعصبي إلى الجنون، وهو ما لا يغيّر الإحساس بالهوية فحسب، بل وجودها الموضوعي. وبالمجمل تُغيّر تلك التحولات هُوية الأفراد فعلياً، وليس بأيّ معنى رمزي أو مجرّد أو متعالٍ.
يميل نص مبروكي إلى جعل اختلافنا حول مشكلة الهوية يبدو وكأنه خلاف لغوي، بل إلى جعل الهوية ذاتها تبدو مسألة لُغوية، وذلك مشياً على عادة فلسفات اللغة والتفكيك والهيرمونوطيقا التي سادت القرن العشرين. وربما أيضاً على عادة الفلسفة العربية المعاصرة بمجملها، حيث تسرح الفلسفة وتمرح في عالم المجرّدات الثقافية الفارغة دون أي تشابك مع الواقع الفعلي “المعاش” أو تداخل مع محدّدات السلطة المسيطرة في المجتمع. لكن هل بقي؛ بعد ميشيل فوكو، أي معنى لتلك الغنائيات المجرّدة في عالم المثل؟ ألم تصبح المعرفة خطاباً يحمل سلطة بذاته، خطاباً يقوّض ويفضح السلطة السائدة أحياناً، أو خطاباً يخدم عمليات التدجين الجماعية التي تسعى إليها السلطة في أحيان أخرى؟ ألم تفارق المعرفة بعد مطارق نيتشه ونسبية آينشتاين وتطوّرية داروين كلّ أشكال الجوهرانية والحقائق المطلقة وثبات الأنواع؟ ألم تصبح الفلسفة خلقاً للفكر وإنتاجاً للحقائق؛ وليست تمثيلاً للحقائق الأبدية، بعد جيل دولوز؟ ألم نتعب (نحن في العالم العربي) من الهُويات الأصلية “القاتلة” التي أوّل ما تستند إليه في أصالتها، وفي تعريف نفسها هو تأكيد اللغة المشتركة التي تأتي عادةً قبل “الأرض والتاريخ” وتؤبدهما؟ ليست مشكلة الهوية مشكلة لغوية، بل إشكالية واقعية نعانيها ونعاينها وجودياً وسياسياً وثقافياً، ونحتاج إلى تفكيكها وإيجاد الطرق العملية لإعادة ترتيبها وتركيبها والتأقلم مع متغيّراتها.
—————————-
محاورة: الهويّة في الاختلاف أم الاختلاف في الهوية؟/ شريف مبروكي
22 مارس 2024
(هذا النص هو الرابع والأخير من أربعة نصوص، تشكّل بمجموعها محاورة بين الكاتب والباحث ماهر مسعود والكاتب والمترجم شريف مبروكي، وتتمحور حول مسألة الهوية وإشكالاتها في العالم المعاصر. يمكن قراءة النص الأول على هذا الرابط، والثاني على هذا الرابط والثالث على هذا الرابط).
يحمل موضوع الهوية شجوناً خاصة وكبيرة هي شجون العصر نفسه، وذلك في جميع الثقافات، وإن كان في ثقافتنا يأخذ طابعاً حاداً ومضنياً بسبب الوضع الذي نعيشه والمرحلة التاريخية التي نمرُّ بها، فقد يغامر المرء بوصف هذا العصر “بعصر انفجار الهويات” وانفجار جميع المعاني والدلالات المرتبطة به، وفي هذا التشظّي والتنوّع الذي يثيره هذا الموضوع تتخالف المقاربات وتتعدّد أشكال الاجتهاد وطرائقه وأغراضه وتتداخل الحقول المعرفية، كلّ منها يدلي بدلوه ومن زاوية النظر المناسبة له، وبالعدّة المنهجية التي يستند إليها، وبالمفردات اللغوية والاصطلاحية التي يتوّفر عليها، علاوةً على الأسلوب الشخصي لكلِّ باحث، وهذا مسعى يغني البحث ولا يختزله في تعريف واحد هو أنّ “الهوية اختلاف”، فهذا التعريف هو من باب تحصيل الحاصل ولا يضيف شيئاً لمفهوم الهوية ولا يغني دلالتها، فهذا التعريف هو نفسه قد ورد لدى أرسطو الذي يمكن تلخيص تعريفه لمبدأ الهوية في أنّ “أ ليست ب”، وهي بذلك تقيم في اختلاف جوهري عن كلّ ما عداها، أو بحسب التعريف الديالكتيكي الهيغلي أنّ “أ ليست هي لا أ”، وكلّ ما فعله المتأخرون من حداثيين وما بعد حداثيين هو التنويع على هاتين الصيغتين بطرق مختلفة بحسب الرؤية وبحسب السياق وبحسب الغرض. ويمكن القول، بالإجمال، أنّ جميع هذه المقاربات لا تنفي بعضها بعضاً بل تثريه، تلقّحه وتخصبه بشيء من خارجه وتجعله يدرك نقص مقاربته، الناقصة ضرورةً إن ابتغت السداد المعرفي والرؤية الموضوعية، وهذا هو معنى الكثرة، أو “الجذمور” الذي يؤسّس المفاهيم في تعدّد أصولها ومنابتها.
وبمكنتي القول إنّني استفدتُ شخصياً من النقاش مع الأستاذ ماهر مسعود حول مفهوم الهوية وسوف آخذ بالكثير من النقاط التي أوردها وأحوّر من رؤيتي ومن طريقتي في تناول الموضوع، سيما أنّني اكتفيتُ في مقاربتي بالجانب النظري التجريدي وحده دون تشابك مع تعينات الهوية في الواقع، وذلك، مرمى آخر نسعى إليه، ولكنّه قد يتطلب أكثر من مقال، وهذا المدخل النظري ارتأيتُ أنّه أمرٌ لازب في البدء لتبيّن نجاعة المفهوم نظرياً إن هو رام تطبيقه على الواقع العياني. وكان يحدوني في ذلك أن ننتقل لاحقاً بالنقاش، إن أمكن الأمر، إلى إشكالية الهوية في الممارسات السوسيولوجية والسوسيوثقافية والسياسية والأنثروبولوجية والتحليلنفسية، سيما أنّ مقاربات هذه الممارسات أصبح لديها مدوّنة ضخمة وغنية تتجاوز المقاربة الفلسفية وإن كانت تستند إلى بعض معطياتها. فمن الناحية المفاهيمية الصرفة، يُستخدم مصطلح الهوية على نطاق واسع ولكن نادراً ما يتم تعريفه بدقّة وفق حدّ صارم ومتناهٍ. فهو مفهوم شامل ذو حدود غامضة، “فالهوية هي نوع من المنزل الافتراضي الذي من الضروري بالنسبة لنا أن نرجع إليه لشرح عدد معين من الأشياء، ولكن دون أن يكون له وجود حقيقي على الإطلاق”، كما يشير كلود ليفي شتراوس في ختام الندوة التي أجراها حول هذا الموضوع في محاضرة شهيرة في الكوليج دو فرانس (1979). فتصوّر الهوية يقع عند مفترق طرق واختصاصات وتداخلات فرعية عدّة.
ولكن، في الواقع، وبرغم التفكيك المفاهيمي الذي تعرّض له مفهوم الهوية، يحاول كلّ فرد، مهما كانت مشاربه وأصوله، تعريف نفسه على أنّه ذاتٌ محدّدة بناءً على عناصر ثابتة وأخرى متباينة، عناصر للذات نفسها، وعناصر للغير، أو كما يؤكّد كلود دوبار في كتابه “أزمة الهويات” (الترجمة العربية، 2008) بـ”الهويات للغير والهويات للذات”، فالذات تقوم دائماً على أنماط من المفاضلات والتعميمات، فهي “مماثلة الآخر ومماثلة مع الآخر”، فالأمر يتعلّق دوماً بسياق التعريف الذي تندرج فيه. فمن ناحية، ثمّة رغبات وتوّقعات وإسقاطات وانتظارات، ومن ناحية أخرى ثمّة المعايير والقواعد والمثل وأساليب التصنيف التي تنتجها كلّ بيئة لتعيين كلّ فرد من الأعضاء الذين يتكوّنون منها والاعتراف بهم. كتب خورخي لويس بورخيس: “إننا جميعاً نشبه صورة ما هو مصنوع منّا”، لتفسير الازدواجية بين ما يدفعنا ذاتياً “لنكون أنفسنا عينها”، وما يأتي من الآخرين في تكوين أنفسنا. الهُوية هي فكرة نفسية اجتماعية بارزة وأساسية لا مندوحة عنها مهما كانت درجة التشظّي التي تتعرّض لها. فالهوية تشير إلى الشعور بالوجود، وبالوحدة والتماسك لدى الشخص، وإلى ما يعرّفه على أنه كائن فريد، ومحدَّد، ومتميّز، وفي النهاية إلى كائن خاص. لكن هذه الهوية “لا يمكن أن تأتي إلا من الخارج، أي من المجتمع”، كما تقول فرانسواز هيريتيه في كتابها “عن الهوية”، وهذا يعني أنّ الفرد يُعيَّن بمجموعة من الصفات الاجتماعية والقانونية التي تمنحه مكانًا في سلسلة الأنساب، وفي النظام الاجتماعي، وفي مجمل السيرورات الاجتماعية التي يعيشها ويتقاطع معها. فهي تتكوّن من مجموعة الخصائص والصفات التي تجعل الأفراد أو المجموعة ينظرون إلى أنفسهم على أنّهم كيان محدّد، وأنّ الآخرين ينظرون إليهم على هذا النحو ويعترفون بهم، أو لا يعترفون بهم، على هذا النحو. ويجب فهم هذا التصوّر من خلال تمفصل العديد من السلطات والمرجعيات الاجتماعية، سواء كانت فردية أو جماعية، كما يقول ميشال كاسترا. ولكن هذا لا يعني أنّ الهوية هي مجرّد ميكانيزم اجتماعي أو ثقافي أو سيكولوجي يقيم فقط في فكرة الاختلاف الهووي ولا قوام له بذاته.
الإنسان لا يتحمل فراغ الهوية، هذه هي روح ما قلته في مقالي السابق. وفي الحقيقة كنتُ أوّد ألا أردّ بشكل سجالي على ردّ الأستاذ ماهر مسعود على ردّي عن مقال سابق له، بل كنت أودّ أن يُدفع النقاش إلى مستوى الجدل الحجاجي، وتصعد فيه الحجة إلى مستوى يليق باسمها، وليس التوّسل بمجموعة من الأمثلة والرؤى المختزلة سأذكر بعضها فقط، وليس كلّها بسبب ضيق المساحة ومحدودية الموضوع.
في مقاربة بعض المفاهيم الحسّاسة، يتميّز المثقف العربي عموماً، ولا أستثني نفسي، بقدرة فائقة على التصنيف ووضع الأشخاص والأفكار والكلمات في خانات جاهزة، وإن كان المرء يأمل أن يرتقي هذا التصنيف إلى تصنيف علمي نسقي كما تفعل البيولوجيا مثلاً، فالتصنيف علم دقيق إلا أنّه قد يصبح، حين يُمارس كيفما اتفق، إلى عائقٍ ذهنيٍ ومعرفيٍ بائن الخور يضع كلّ ما يقوله الآخر في خانات أو فئات جاهزة وبحسب مقولات مضادة جاهزة أيضاً، لا لشيء إلا للإطاحة به وبآرائه، وذلك بحثاً عن الصدى والاستقطاب، وبدافع وعي ذاتي موهوم بامتلاك الحقيقة وصوابية الخطاب الذي يصدر عنه.
في كتابه “مضخات الحدس وأدوات أخرى للتفكير” يقدّم لنا الفيلسوف الأميركي، دانيال دينيت ترياقاً نظرياً ونفسياً ضدّ الميل إلى تصوير الخصم بطريقة كاريكاتورية أو انتقاصية، متمثلاً في قائمة من القواعد التي صاغها قبل عقود خلت عالم النفس الاجتماعي أناتول رابوبورت، صاحب المبدأ الذائع الصيت في استراتيجية نظرية اللعب، المسمّى بمبدأ “العين بالعين”. يلخص دينيت هذا الترياق أو كيف تكتب ردّا نقدياً ملائماً وناجحاً في أربع نقاط:
(1): يجب أن تحاول إعادة التعبير عن موقفك وغايتك بشكل واضح وحيوي وعادل كما لو أنّك تقول: “شكراً، أتمنّى لو أنّني فكرتُ في صياغة الأمر بهذه الطريقة”.
(2): يجب عليك إدراج أي نقاط اتفاق مع محاورك (خاصة إذا لم تكن مسائل اتفاق عام أو واسع النطاق).
(3): يجب أن تذكر أي شيء تعلمته من خصمك.
(3): عندها فقط يُسمح لك أن تقول كلمة دحض أو انتقاد.
وهذا المبدأ الحجاجي لخّصه دونالد دافيدسون بـ “مبدأ الإحسان”، وهو مبدأ يقوم على فهم أطروحات الآخر ومقاصده بإضفاء الحدّ الأقصى من المعقولية عليها. والنظر إلى أنّ ثمّة في خطاب الآخر شيئاً مهماً يمكن أن نبني عليه ونوسّع نطاقه بدل الاكتفاء بمهمة دحضه مهما كان الثمن، وأنّ ثمة حجة ما، بغض النظر عن اتفاقنا مع مضمونها أو لا، يمكننا الردّ عليها بحجة مضادة دون وصفها بطريقة هزلية، وبأنّ خطابه له صوابية ما من الزاوية التي ينظر بها إلى الواقع، باعتبار أنّ الواقع لا متناهٍ، وكلّ ما يستطيع الباحث تقديمه هو مقاربة ذاتية، خاصة، وبالتالي جزئية للواقع وهذا هو التنسيب الحقيقي للأمور والرؤى والمقاربات ولا علاقة له بنظرية النسبي والمطلق في فيزياء أينشتاين التي يلجأ إليها كاتب المقال كمثال لدعم تصوّره لمسألة الاختلاف وهما أمران بعيدان عن بعضهما بعضاً البعد كلّه، وسأعود إلى هذا المثال.
يفتتح مسعود مقالته بالجملة التالية: “على الرغم من اللغة الفلسفية العالية لمقال الأستاذ شريف مبروكي، إلا أنّ الأفكار المطروحة فيه والمعاني التي أراد الدفاع عنها لم تكن فلسفية بما فيه الكفاية”. تقول هذه الجملة شيئين، أولاً: إنّ اللغة منقطعة عن معانيها ودلالاتها وتسبح في فراغ سديمي، فهي فلسفية بينما معانيها ليست فلسفية، وهذا تناقض بائن، فالفلسفة هي عينها اللغة التي تكتب بها، والفكر عموماً لا يستطيع أن يكون دون لغة تعبّر عنه، فليس هناك فكر في ذاته منقطع عن إمكان قوله في لغة ما، هناك ثمّة فلسفات كتبت شعراً، وهناك أخرى كتبت شذراً ونيتشه أكبر مثال على ذلك. ثانياً، لا أحد يستطيع أن يقول إنّه يكتب في الفلسفة بما فيه “الكفاية”، لأنّ ذلك يعني أنّه أغلق الأمر المعرفي لأنّ ما يقوله “كافٍ” فلسفياً. ويمكن للمرء أن ينتظر من كاتب المقال أن يقول هو نفسه، بدلاً عن ذلك، شيئاً فلسفياً “كافياً” يكون لنا زاداً لا نهائياً يكفينا مؤونة الطريق الفلسفي. ثم يعتبر مسعود أنّ دفاعي عن مفهوم “الأزمة” المنسوب إلى الهوية أنّه “تقويم كلاسيكي”، فمفهوم “الهوية في طرح المبروكي إذاً أفلاطوني بالكامل، ومن هنا كلاسيكيته”، في الحقيقة أطمح أن أكون أفلاطونياً، أو كلاسيكياً، فهذا أمرٌ لا ينتقص مني ولا من الفلسفة، فالجميع الآن يعودون إلى أفلاطون، ومنهم الكثير من الحداثيين وما بعد الحداثيين، ومنهم آلان باديو، على سبيل المثال، وخصوصاً في كتابه الأخير “جمهورية أفلاطون” الصادر سنة 2016، حيث يعيد النظر في أهمية الحوارات السقراطية وبناء الشخوص المفهومية وسبل الفكر في تدبير المدينة إلخ، وآخرون، فأفلاطون يبقى مرجعاً أساسياً لا يمكن نسيانه أو تجاهله عندما نتكلم في الشأن الفلسفي وليس في السجال الخطابي، هذا إذا ما فهمنا أنّ الفلسفة نشاط “جذموري” كما يقول دولوز الفيلسوف العزيز على قلب مسعود، وعلى قلبي أيضاً. ثم يربط كاتب المقال آلياً بين الأفلاطونية والكلاسيكية ويعتبر الثانية نتيجة للأولى، وهذه مغالطة فالكلاسيكية هي أسلوب في الكتابة والفكر وليست مدرسة ونهجاً فلسفياً قائماً بذاته، فهي بحسب ماتيو كيسلر في مقاله الرائع عن كلاسيكية نيتشه: “الكلاسيكية هي الوضوح والبساطة شكلاً ومضموناً للتفكير الفلسفي في الوجود، إذ يصبح الشكل بعد ذلك هو المضمون بمعنى ما هو أساسي، ولا يمثل مجرد “شكل” أو تلبيس “لمضمون” سبقه موجود في استقلال تام عنه”. ولكني لا أظن أن الأستاذ مسعود يقصد هذا المعنى الدقيق وإنّما يعني أنّ ما تكتبه وتقوله قديم، وهذا في الحقيقة تصنيف يقوم على مغالطة أخرى مشهورة هي “مغالطة التوسل بالحداثة”، حيث يدّعي المرء بشكل مبتسر وتعسفي أنّ فكرةً ما، أو حجّةً ما، هي صحيحة ومتفوقة، حصرياً لأنّها فقط جديدة وحديثة.
هذه النزعة التصنيفية المتسرّعة قادت صاحب المقال منذ البدء إلى تضييق النقاش واختزاله حول مقولات تجاوزها الفكر النقدي منذ عهود، ألا وهي وسم خطاب الآخر “بالمثالية” وبنزعة سياسية “محافظة”، فلم يعد أحد يقول للآخر اليوم أنت “مثالي”، فكلّنا حين نكتب في الفلسفة نكون أقرب إلى المثالية ما دمنا نتعاطى مع المفاهيم والمجرّدات، ونتحدّث عن المعايير والقيم والرؤى والأفكار، فهي كائنات مثالية قابلة للتجسّد في ممارسات وغير قابلة بآن كما يذهب ماكس فيبر. ولكن هذا الانزلاق التصنيفي يتحوّل أحياناً إلى توجيه تهم من قبيل أنّ حجة الآخر تسوّغ الدكتاتورية أو تشرعنها! يقول مسعود حرفياً: “ومن هنا احتفال المبروكي بتعبير بول ريكور في وصف الهوية بأنّها “حضورٌ للغياب”. (فكّر في تشابه أو تلاقي هذا الطرح بالعموم مع الصيغة التي تقوم عليها كل الديكتاتوريات، فلا تقوم الديكتاتورية ولا يخاطب الطُغاة في كل مكان إلا الحس العام و”روح الشعب” والهويات الجمعية لدى الناس والحشود، أولئك الناس الذين أول ما تقوم به أي ديكتاتورية هو تهميشهم والتعالي عليهم وعدم الاعتراف بأهليتهم لفهم السلطة أو لحكم أنفسهم)”. وبدوري أتساءل عن معنى هذا الاستخلاص العنيف وغير المفهوم من مقدمة إلى نتيجة لا علاقة منطقية بينهما، إذ كيف يمكن لجملة “حضور للغياب” التي أوردها بول ريكور في تحليله لمسألة الذاكرة وعلاقتها بالهوية، أن تكون صيغة تؤدّي إلى الدكتاتورية؟ والمقال مليء بهذه القفزات من شيء إلى شيء دون روابط منطقية علاوةً على النبرة الهازئة في بداية الجملة “ومن هنا احتفال المبروكي”، وهذه الجملة مثل جمل أخرى عديدة تتوّسل هذا الضرب من اللغة القائم على مغالطة مشهورة أخرى، ألا وهي “مغالطة التوسل بالاستهزاء”، حيث يلجأ الكاتب إلى التقليل من شأن حجة الآخر بالاستهزاء منها.
ثمّة أشياء أخرى عديدة ينتابها الخور المنطقي والمغالطات من عدّة جهات في مقال مسعود، لن آتي عليها كلّها بسبب ضيق المجال، مثل الاستسهال في إدراج الأمثلة من حقول أخرى لا تتعلّق بموضوع النقاش، مثل مفهومي النسبي والمطلق عند آينشتاين، وهما مفهومان غريبان عن متن النقاش وغرضه، وذلك لدعم وجهة نظر عامة وذاتية كيفما كان وبأيّ ثمن، فمفهوم الهوية هو نسبي ومطلق بآن ولكن في إطار مختلف الاختلاف كلّه عن فيزياء أينشتاين، فالانتقال من التصوّرات الفيزيائية الدقيقة إلى سجالات الكتابة التنظيرية العامة هو انتقال تعسفي وغير معرفي.
لا يسعني، لكي أختتم، إلا أن أشيد بما قرأته للأستاذ ماهر مسعود في هذا المقال، وفي غيره، بما يمتاز به من حيوية فكرية وقدرة على إثارة المشكلات العويصة ومحاولة الغوص في أبعادها المختلفة.
العربي الجديد
———————–
الفلسفة والهوية/ حسام الدين درويش
17 ابريل 2024
أثناء كتابتي لرسالةِ الدكتوراه في الفلسفة، وبُعيدَ حصولي عليها، من جامعة بوردو الثالثة في فرنسا، أقمت في إنكلترا واشتغلت فيها عامل بناءٍ لأشهرٍ طويلةٍ نسبيًّا. وكانت ردود فعل زملائي العمال، ورؤسائي في العمل، تتفاوت بين استغراب ممارستي لهذا العمل الذي لا يتناسب مطلقًا مع تأهيلي أو اختصاصي الأكاديمي، أو الحديث الساخر، غالبًا، عن الفلسفة. وبطبيعة الحال، لم يكن لدى أغلب زملائي معرفةٌ (واسعةٌ) بماهيةِ الفلسفة، لكن أذكر أن أحدهم كان يُمازحني أو يسخر من الفلسفة، بإشارته إلى أنّها تتناول أسئلةً من نوع “من أنا؟ (؟who am I). وكان يكرّر هذا السؤال بطريقةٍ كانت تُثير الابتسامة على الأقل، والقهقهة على الأغلب. وعلى الرغم من طرافةِ السؤال الظاهرة، فقد كنت ومازلتُ أعتقد مع فلاسفةٍ كثيرين، من سقراط إلى دريدا وريكور مرورًا بنيتشه ودلتاي وفلاسفة كثيرين، بصعوبةِ الإجابة عن هذا السؤال، وبفلسفيته، وبالحاجة إلى تفكيرٍ وتفكّر، وإلى آخر لمحاورته ومعرفته، من أجلِ سبر آفاق الإجابة عنه.
لم يكن زميلي العامل المذكور مخطئًا في اعتقاده بمركزية هذا السؤال في الفلسفة، وبتعبير هذا السؤال عنها، أو تمثيله لها. ويبدو ذلك واضحًا في اختيار هذا السؤال، سؤال الهُويّة، ليكون أوّل موضوع ﻟ”مدونة “محاورة””، في موقع العربي الجديد، والتي استضافت فيلسوفين عربيين (ماهر مسعود وشريف مبروكي) في إطار خطتها لاستضافةٍ شهريةٍ ﻟ “كاتبين أو كاتبتين يتحاوران/ تتحاوران حول مسألة تهمهما، وذلك في محاولة للاحتفاء بالحوار والاختلاف والرأي الآخر”. وعلى الرغم من أنّ “شهادتي في الفلسفة مجروحةٌ”، بمعنيين متناقضين لهذا التعبير، فإنّني أشهد أنّ لا مقاربة إلا المقاربة الفلسفية لمسألة الهُويّة، بمعنى أنّها المقاربة الوحيدة المناسبة لتناول هذه المسألة تناولًا فكريًّا “موضوعيًّا” ورصينًا متناسبًا مع تعقيد المسألة، ومع كونها ليست مسألة واقع تنبغي معرفته فحسب، ولا شعور ينبغي سبره، أو وعي ينبغي امتلاكه فقط، وإنّما هي، أيضًا وخصوصًا، رؤيةٌ معياريةٌ لما ينبغي أو يُراد له أن يكون.
وفي كلّ الأحوال تمثل مسألة الهُويّة إشكاليةً يصعب حسم الجدل بين الثنائيات أو المثنويات المكوّنة لها بجدلٍ أو تركيبٍ إيجابيٍّ، كما يصعب تقبّل أو حتى قبول حالة الجدل السلبي بين الثنائيات أو المثنويات المذكورة. ولهذا السبب، غالبًا ما يتم حسم الإشكالية المذكورة بطريقةٍ تعسفيةٍ وإرادوية وأحاديةٍ. ومع الفلسفة فقط، يمكن الحفاظ على الطابع الإشكالي للمسألة، لكونها تحوِّل الأسئلة إلى تساؤلاتٍ، وتُظهر الإشكاليات المحايثة للإجابات المقدّمة، وتبيِّن عدم إمكانية الركون إليها وإلى كلّ الإجابات الأحادية الاختزالية وهي السائدة والمهيمنة في هذا المجال عمومًا. وهكذا تظهر في الفلسفة إجابات من نوع “الذات عينها آخر” و”الهوية هي الاختلاف” و”الاختلاف هو الهوية”. وفي كلّ الإجابات المقدّمة، تبقى المسألة مفتوحةً وغير محسومةٍ أو غير قابلةٍ لأن تُحسم حسمًا كاملًا ونهائيًّا.
ويتفق ماهر وشريف على وجود علاقةٍ خاصةٍ و/ أو وثيقةٍ بين الفلسفةِ وسؤال الهُويّة. فيشدّد شريف على أنّ “سؤال الهوية هو سؤال الفلسفة بامتياز”. ومن جانبه، يؤكد ماهر “أصالة” مشكلة الهُويّة وأهميتها وراهنيتها، فيكتب: “ليست مشكلة الهوية مشكلة لغوية، بل إشكالية واقعية نعانيها ونعاينها وجودياً وسياسياً وثقافياً، ونحتاج إلى تفكيكها وإيجاد الطرق العملية لإعادة ترتيبها وتركيبها والتأقلم مع متغيّراتها”. ويبدو أنّ ذلك ينطبق، انطباقًا خاصًّا وكبيرًا، على العصر الراهن الذي يرى كثيرون أنّه يستحق اسم “عصر الهويات”، ويحاكي المبروكي تلك التسمية بوصفه ﺑ”عصر انفجار الهويات”. ويذهب ماهر المذهب نفسه تقريبًا، حين يتحدّث عن كونِ “الحياة المعاصرة بتعقيدها التكنولوجي وسرعة تغيّراتها وكثافة ضغوطها المعولمة” تخلق “أزمة هوية عميقة ومركّبة بالمعنى الوجودي للأفراد في كلّ مكان تقريبًا”.
في متابعةِ المقالات الأربعة التي كتبها الفيلسوفان المذكوران مناصفةً، بمعدل مقالٍ كلّ أسبوعٍ، يمكن للقرّاء أن يقعوا في حالةٍ تشبه حالة أبو فهمي/ أبو جندل في الاسكتش “الشهير” الذي يجمعه مع سامية الجزائري والمعنون ﺑ “أعطيه ولا ما أعطيه”. ففي ذلك المقطع التمثيلي القصير، تستشير سامية “خانم” أبو جندل في خصوص قبول طلب أحد الشباب الزواج من ابنة أختها. فتشير إلى إيجابية لدى الشاب، فينصحها أبو جندل بأن تعطيه ابنة أختها، أي تزوّجه إياها، ثم تشير إلى سمة سلبيةٍ فيه أو في وضعه، فيغيّر أبو جندل رأيه، وينصحها بأن “لا تعطيه”. وتتوالى حجج سامية الجزائري المتناقضة، وتتذبذب ردود فعل “أبو جندل” بين “عطيه” و”لا تعطيه”. فحين تتحدّث عن “أخلاقه المنيحة”، يقول لها “عطيه”، لكنها سرعان ما تُشير إلى فقره، فيغيّر أبو فهمي رأيه ويقول لها “لا تعطيه”، فتشير إلى احتمال أن يرث الشاب من عمه، ويصبح غنيًّا، فيعود مرّة أخرى إلى رأي أن “تعطيه..، إلى أن يعلن “في النهاية” أنّها قد “نفخت قلبه”، ويستغيث بالآخرين، لنجدته، لمعرفة ما الذي ينبغي لها فعله في هذا السياق: “تعطيه، ولا ما تعطيه؟”.
إذا أخذ القارئ كلّ مقالٍ، من سلسلةِ المقالات الرباعية المذكورة، على حدةٍ، بدا له، على الأرجح، أنّ الأطروحة أو الأطروحات الرئيسة التي تتضمنها مقنعةٌ ومعقولةٌ جدًّا، ليس بسببِ توّفر أو تَوافر حججٍ ومعطياتٍ تسمح بالتثبّت من “واقعية” أو “موضوعية” تلك الأطروحة أو الأطروحات، وإنّما بسبب بنائها الكلّي، ومبانيها المُحكمة، ومعانيها أو أفكارها المفيدة والمثيرة للتفكير والبحث والقراءة. لكن، عند قراءة الآراء المضادة لها، في مقالِ أو مَقالي الطرف الآخر، يتسرّب الشك إلى نفس القارئ، ويخرج بيقينٍ أقل من ذاك الذي دخل به ذلك التناول والنقاش الفلسفي لمسألة الهوية. وقد بدا أحيانًا، أنّه ينبغي للقارئ أن يختار بين طرفين يُقصي كلٌّ منهما الآخر أو يُساجله، مختارًا أو مضطرًا، بدلًا من “دفع النقاش إلى مستوى الجدل الحجاجي، وتصعد فيه الحجة إلى مستوى يليق باسمها، وليس التوّسل بمجموعة من الأمثلة والرؤى المختزلة”، وفقًا لتعبير شريف مبروكي. وعلى الرغم من ذلك، وبسببه أو بفضله، أو بغضّ النظر عنه، قدّم الفيلسوفان مقالاتٍ كاملة الدسم، حيث تضمنت الكثير من المعلومات والأفكار والاقتباسات والمفاهيم والإحالات المفيدة والعميقة والمهمة. وربّما كانت المقالات مفرطةً في الدسم أيضًا، إذا أخذنا في الحسبان أنّها “مجرّد مقالات”، وليست نصوصًا بحثيةً أو أكاديميةً. وبدا الإفراط المذكور، على سبيل المثال، في العدد الكبير (جدًّا) نسبيًّا من الإحالات على أسماء عشرات الفلاسفة والأعلام والمصطلحات والاقتباسات والنصوص… إلخ. فمستوى حضور الجدل الحجاجي ليس ناتجًا عن السمة السجالية فحسب، بل، أيضًا، عن المحاججة بالأسماء والاقتباسات، بطريقةٍ تشبه “القلقلة والعنعنة الدينية”. وفي كلّ الأحوال، يمكن القول إنّ المقالات الأربعة مليئة بالصياغات الجميلة بمبانيها، والكثيفة والمُوحية بمضامينها ومعانيها، والمثيرة للتفكير أو إعادة التفكير بحدوسها ورؤاها، والمشجّعة على البحث والقراءة، والموّجهة لهما، بإحالاتها واقتباساتها واستحضارها للآخرين.
ربّما كانت مضامين المقالات محكومةً ببنية المحاورة ذاتها، حيث يبدأ أحد الطرفين بطرح فكرته، ثم يقوم الطرف الثاني بمناقشتها، وطرح فكرته أو رؤيته، في الوقت نفسه، ثم يفعل الأمر ذاته الطرف الأول، ليختتم الطرف الثاني “المحاورة”. فقد بدأ ماهر مسعود المحاورة بمقالٍ تضمّن نقدًا بقدر ما تضمّن أطروحة بنائيةً، وربّما أكثر. وهذا يعني أنّه كان يحاور وينقد طرفًا ثالثًا أو أطرافًا أخرى، ولم يكن (بإمكانه أن) يُحاور أفكار محاوره المستقبلي، شريف مبروكي. وفي المقالة الأولى، كان موقف ماهر النقدي انتقاديًّا بالكامل، ولم يكن هناك أيّ ملمحٍ جدليٍّ في موقفه، بل تضمن المقال الأول مثنويةً صريحةً بين طرفٍ (مجهولٍ) يقول بثباتٍ أو بالأحرى جمودٍ جوهرانيٍّ للهُويّة، وطرفٍ آخر (ماهر نفسه) ينتقد الطرف الأول، ويعلن بطلان أطروحته وضرورة التخلّي عنها وتجاوزها. وثمّة “عصابيةٌ فكريةٌ” في الإصرارِ على رفضِ أيّ ثباتٍ في الهُويّة، وفي اختزالها في الاختلاف. وإصرار ماهر على جعل الهوية اختلافًا (محضًا)، يفضي أيضًا، على الأرجح، إلى نتيجةٍ غير مرغوبةٍ ولا مستساغةٍ بالنسبة إليه: جعل الاختلاف هويةً ثابتةً لا تتغيّر، ولا تتبدّل. وفي المقالة الثانية أعلن مبروكي اتفاقه (واختلافه) الجزئي مع النقد الذي وجهه ماهر للنظرة الجوهرانية للهُويّة، لكنه شدّد على أنّ ذلك لا ينفي وجود الهوية، ولا وجود ثبات جزئيٍّ ونسبيٍّ فيها، وأنّ مشكلات الهُويّة وانفجار الهُويّات في العالم المعاصر يمثل أزمةً وليس مأزقًا. لم يلتقط ماهر يدَ الاتفاق التي مدّها له مبروكي، بل استمر متمسّكًا، بثباتٍ، برؤيته المثنوية الصدامية، فعمل على استثمار كلّ ممكنات الاختلاف في نقدِ، أو بالأحرى انتقادِ، رؤية مبروكي، بطريقةٍ تعطي الانطباع بأنّ مبروكي يتبنى الرؤية الجوهرانية للهُويّة فعلًا. وفي المقال الرابع والأخير، أعلن مبروكي اضطراره إلى المساجلة بدلًا من الجدل بالمحاجة، وخصّص جزءًا مهمًّا من نصّه لتبيان الطريقة المناسبة للنقاش ومحاورة الآخر والاختلاف معه. وهكذا أصبحت المحاورة ذاتها هي الموضوع بعد أن كان مفترضًا أن تكون الأداة أو السياق الذي يتم فيه، ومن خلاله، مناقشة موضوعٍ ما، هو موضوع الهُويّة. لكن هذا هو حال الفلسفة دائمًا تقريبًا، فهي فكرٌ تفكريٌّ، أي فكرٌ يفكّر بنفسه، أو ينعكس على ذاته، حتى حين يفكّر بغيره وينشغل بموضوعٍ آخر.
النقطة التي انطلق منها ماهر بقيت متحكّمةً في مسيرة (أو مظاهرة) المحاورة، رغم أنّ (معظم) الأفكار التي قدّمها مبروكي تختلف، جزئيًّا على الأقل، عن الأفكار التي حرص ماهر على نقدها والاختلاف عنها في مقاليه على حدٍّ سواءٍ. لكن ذلك سمح للقارئ بفهم النموذج المنتقَد في أنقى صوره، كما لو أنّه نمط مثاليٌّ بالمعنى الفيبري. وقد انتقد شريف ميل ماهر مسعود، والمثقفين العرب عمومًا، إلى التصنيف التنميطي للآخر وفق قوالب جاهزة “يضع كلّ ما يقوله الآخر في خانات أو فئات جاهزة وبحسب مقولات مضادة جاهزة أيضاً، لا لشيء إلا للإطاحة به وبآرائه، وذلك بحثاً عن الصدى والاستقطاب، وبدافع وعي ذاتي موهوم بامتلاك الحقيقة وصوابية الخطاب الذي يصدر عنه”. وأخذ شريف على ماهر أنّ مقاله تضمَّن عددًا (كبيرًا) من المغالطات، لم ينجح في تجنيب نصّه الوقوع فيها. ومن بين تلك المغالطات، مغالطة “رجل القش” التي يبدو أنّه رأى أنّ ماهر قد “ارتكبها”، أو “وقع فيها”، أكثر من مرّة. ففي تقديمه الانتقادي لآراء ماهر، زعم شريف أنّ ماهر انتهى “إلى أنّ الهوية هي “ماكينة لتوليد التعاسة”، مع العلم أنّ ماهر، تحدّث عن أنّ مأزق الهُويّة، وليس الهُويّة، “يبدو للوهلة الأولى”، وليس في نهاية التأمّل أو في الحكم الأخير، “وكأنه ماكينة لتوليد التعاسة”.
لا يمكن انتقاد المقالات الأربعة من منظورِ عدم تناولها لهذه الفكرة أو تلك. فكما أشرت آنفًا، تتضمّن المقالات الأربعة كثافةً كبيرةً في الأفكار القيّمة، تتجاوز ما يُفترض أو يُنتظر، عادةً، من مثل هذه المقالات. لكنْ ثمّة فكرةٌ رئيسةٌ بقيت غائبةً أو مغيّبةً، أو ضبابيةً، أو غير واضحةٍ، ولم يتم حسمها بوضوح في المقالات الأربعة، على حدٍّ سواء. لمناقشة هذه المسألة يمكن البدء بتناول السؤال التالي: هل تتناول المقالات البعد المعرفي لمسألة الهُويّة، أم البعد الأنطولوجي/ الوجودي، أم كلا البعدين، معًا؟ فعلى سبيل المثال، هل يعني الحديث عن أزمة الهُويّة أو انفجار الهُويّات أنّ تلك الأزمة تطاول وجود الهُويّة ذاته، أم تطاول الوعي بهذا الوجود، أم أنّه لا فرق بين الأمرين؟ تنوس المقالات الأربعة بين هذين البعدين، من دون توضيح ذلك النواس، ومن دون حسم البعد الذي يتم تناول المسألة من خلاله. فتارةً يجري الحديث عن الهُويّة، بوصفها مسألة وجودية/ أنطولوجية ذات استقلالٍ نسبيٍّ عن الوعي بها، وتارةً أخرى، يتم الخلط أو المزج أو التوحيد بين الهُويّة والإحساس بها أو الوعي بها أو الشعور بها، حيث تكون الهُويّة شعورًا، على سبيل المثال. وربّما كان الخلط أو المزج بين البعدين المعرفي أو الشعوري والأنطولوجي/ الوجودي في مقالتي مبروكي أكبر وأوضح، خصوصًا أنّ ماهر يشدّد، في ختام مقاله الثاني، على فاعلية الذات أو الفلسفة في خلق الحقيقة، وعلى أنّ دورها لا يكمن في الكشف عن وجودها الناجز مسبقًا. ويمكن أن تتقاطع فكرة ريكور التي يتبناها مبروكي عن سردية الهُويّة، أو الهُويّة السردية، مع فكرة وجود دورٍ للذات في تحديد هُويّتها. فالهُويّة ليست مجرّد وجودٍ ناجزٍ مستقلٍّ عن الذات الإنسانية الفاعلة، وليست مجرّد شعورٍ أو إحساسٍ أو وعيٍ بالوجود المذكور، وإنّما هي أيضًا وخصوصًا، ما تريد ذات الهُويّة أن تكونه. فالهُويّة لا تُختزل في ما هو كائنٌ، سواء وجوديًّا أو معرفيًّا أو شعوريًّا، وإنّما تتضمن دائمًا بعدًا معياريًّا أو إراديًّا يتمثل في ما تريد ذات الهُويّة أن تكونه. فنحن لسنا مجرّد نسبٍ لاإراديٍّ وإنما انتسابٌ إراديٌّ أيضًا. وإذا استخدمنا لغة إدوارد سعيد، في “أماكن العقل”، نقول نحن لسنا بنوة filiation، (فقط)، وإنما نحن تبنٍّ affiliation، (أيضًا). وبهذا المعنى لا تكون الهُويّة مجرّد قدرٍ، بل تكون مصيرًا (أيضًا). فليست هُويّة الفتى مرتبطةٍ بما كانه أبوه (فقط)، وإنّما هُويّته بما يريد أن يكونه (أيضًا). في هذا الجدل بين النسب والانتساب، بين الإرادي واللاإرادي، بين البنوة والتبني، بين الفردي والجماعي أو الجماعاتي، بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، بين القدر والمصير، بين الثبات والاختلاف، بين الاستمرارية والتغيّر، بين الذاتية والموضوعية… إلخ، تكمن وتظهر الهُويّة التي توجد وتنوجد، ونجدها وتجدنا، ونوجدها وتوجدنا، ونتواجد معها وبها.
———————–
===================




