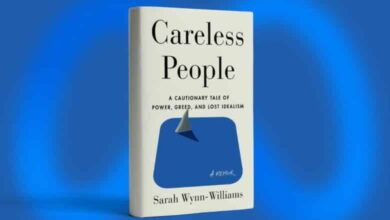جويس منصور… شاعرة الشهوة المفترِسة/ رشيد وحتي

6 تموز 2024
تعتبر جويس منصور (1928 ـــ 1986)، التي أعادتها «منشورات المتوسط» عبر إصدار أعمالها النثرية الكاملة تحت عنوان «قصص مؤذية» (ترجمة محسن البلاسي) من وجوه الحركة السّرياليّة الأساسيّة التي تجدّدت بها دماؤها بعد الحرب العالميّة الثانيّة، ضمن ما اصطلح عليه باسم «الرّكب الثالث» بعد جيل المؤسِّسين وجيل ما بين الحربين. ولدت منصور لأبوين مصريّين من الطائفة اليهوديّة التي تعود جذورها لمدينة حلب السوريّة. ولكونهم من اليهود الشّرقيين (السّفارديم)، فإنّ لغة الحديث لديهم في البيت كانت خليطاً من العبريّة والإسبانيّة.في تلك المدة، افتتحت زوجة الوزير محمود رياض، ماريا كافاديا صالوناً للقاءات الأدبيّة في القاهرة، وكانت الأولى في فتح إقامتها الباذخة في الزمالك لأعضاء الفرع المصريّ للحركة السّرياليّة: «جماعة الفنّ والحرّيّة»، الّتي أسّسها في 1938 جورج حنين، ورمسيس يونان وفؤاد كامل. وفي هذا الصالون بالذات، التقت جويس بحنين الذي كان منشّط النّقاشات الرئيسي، وهناك اكتشفت الشاعرة روح الحركة السّرياليّة. في تموز (يوليو) 1952، مع ثورة الضباط الأحرار، لم تحسّ أسرة جويس بأيّ انزعاج أو بما يدعوها لمغادرة البلاد.
مع صدور ديوانها الأوّل «صرخات» (1953)، صار الكتاب حديث الصالونات الأدبيّة في القاهرة والإسكندريّة، حديثاً بطعم الفضيحة والصّدمة أحياناً. فوراً، نال إعجاب جورج حنين وكتب عنه تعليقاً في كانون الثاني (يناير) 1954: «من دون أيّ أدنى إعداد أدبيّ، متأكّدةً من استخفافها بالمعايير الشّعريّة، أعطت جويس منصور لحدوسها صوتاً. نحن هنا في أجواء الكلمة اللحظيّة التي تعتبر امتداداً للجسد دون حلول تمكّننا من المتابعة. لكلّ عضو من الجسد لغته كتدفّق النسغ في النّبتة، كبركة دم».
أما السّرياليوّن في باريس، فقد اعتبروا جويس، مُذَّاكَ، واحدة منهم، يَتَذَكَّرُ الشاعر الفرنسيّ ألان جوبير: «كان أندري بروتون يحدّثنا عن هاته القصائد بحماسة». وتحتوي مكتبة ذخائر أندريه بروتون نسخة من الديوان كانت قد أرسلتها إليه جويس، بتوصية من جورج حنين، مرفَقة بالإهداء التالي: «إلى السيّد أندريه بروتون بعض هاته الصّرخات تحيّة. ج. م». وما كان من رائد الحركة السّرياليّة إلا أن ردّ برسالة اعتبرتها جويس «يداً ممدودة لها» ودعوة للالتحاق بالحركة السّرياليّة.
ما يمكن استخلاصه من تلقي ديوان جويس الأوّل هو أنّه، رغم نشره وتوزيعه في رقعة ضيّقة وفي نسخ محدودة، حقّق لها صيتاً مدوّياً في أوساط فرعي الحركة السّرياليّة المصريّ والباريسيّ. كما يؤكّد نزوع شعرها السّرياليّ قبل انتسابها التنظيميّ للحركة بعد هجرتها الاضطراريّة إلى فرنسا. بالنّسبة إليها، نولَد سرياليين، ولا نصير كذلك. استمراراً للجذوة الشعريّة نفسها، وتماشياً مع روح السرياليّة، أصدرت جويس ديوانها الثاني «تمزّقات» (1955)، ولاقى الاستحسان نفسه لدى أعضاء الحركة في فرعيها في القاهرة وباريس.
مع أزمة قناة السويس والعدوان الثلاثي، اضطرّت جويس، مع زوجها سمير منصور، إلى مغادرة مصر في أيلول (سبتمبر) 1956. وقبل ذلك، كانت السلطات المصريّة قد قدمت إلى إقامتهما، وصادرت ممتلكات العائلتين وسجنت أب جويس وإخوتها، ليطلق سراحهم بعد شهر من الاعتقال. بعدها، لم تعد الشاعرة قطّ إلى مصر.
بين 1956 و1966، ستجد جويس نفسها في خضمّ الحركة السّرياليّة، لا أسلوباً وجماليّة شعريّة فقط، بل أيضاً انتساباً تنظيمياً، نشاطاً جماعياً يومياً: صار الإسهام بالقصائد المشبوبة والقطع النثريَة الملتهِبة، مع نشرِها في المجلات والمطبوعات السّرياليّة مقروناً بتوقيع البيانات الناريَّة. وبعدما أصبح التحاق الشّعراء نادراً، جاء إسهام جويس دفعة ودفقات جديدة في دماء الحركة السرياليّة بعد الحرب العالميّة الثانية وزخماً أغنى إنجازاتها الشّعريّة، في وقت كانت فيه المجموعة السرياليّة في باريس ـــ بعد عودة أندريه بروتون من منفاه الأميركي ــــ تمرّ بمدة حالكة، تشكو من طعنات وتصدّعات وفقر في الروافد الجديدة، إذ شكّك كثيرون من المتتبّعين بقدرتها على الاستمرار والانسجام كجماعة. لكنّ جويس منصور كانت بطبعها مستقلّة عن الجماعة، تتقصى الأخبار ولكنّها تأخذ مسافة كبيرة إزاء الجماعة.
في كانون الثاني (يناير) 1968، تتوّجه مجموعة من السرياليين، ضمن وفد فرنسيّ، إلى كوبا، للمشاركة في مؤتمر هافانا، الذي دُعي إليه مثقّفو العالم بهدف مناقشة مشكلات القارات الثلاث. توزّعت أشغال المؤتمر على خمس لجان، شاركت جويس في الأخيرة منها التي تمحورت حول مشكلات الابتكار الفنّي والنشاط العلميّ والتقنيّ. كانت مواقف جويس في تدخّلاتها أثناء مناقشات اللجنة تدافع عن استقلاليّة الفنان عن أيّ توجيه سياسي، مع الدفاع عن قيم الثورة والحريّة، في تنافٍ مع جَرَب الواقعيّة الاشتراكيّة الذي لم يُصِب بعد، آنذاك، الفنانين والقيادة السياسيّة في كوبا. ولو أنّ الشاعرة جاءت لكوبا ضمن الوفد الفرنسيّ، فإنّها كانت تقدّم نفسها كمصريّة، ما أثار احتجاج الوفد المصري!
في ربيع 1968، نأت جويس بنفسها نهائياً عن الجماعة السرياليّة، بعدما بدأت تدبّ فيها انشقاقات وصراعات هامشيّة أوصلتها إلى باب مسدود ونزاعات حول قيادتها. لكنّها بقيت على صلة شخصيّة بغالبيّة الأعضاء الذين رفضوا إعلان جان شوستر عن حلّ الحركة كتنظيم في 1969، في خرق سافر لمبادئ العمل الجماعيّ، ومن دون استشارة النّشطاء الباريسيين ولا باقي الفروع السّرياليّة في العالم.
توفيت جويس منصور في بيتها في 27 آب (أغسطس) 1986، بعد صراع طويل مع السّرطان. وقد حيّتها الصّحف وباقي وسائل الإعلام كآنسة غريبة، وطفلة مِسْكِيَّة في الحكاية الشّرقيّة، كشاعرة سرياليّة ذات أصول مصريّة، كأهمّ وجه في الجناح المصري للحركة السّرياليّة، كأجمل سرياليّة، كنموذج للجمال الشرقيّ رغم بصرها الحسير، كمواصِلة لجذوة الحركة السّرياليّة – بصفتها نشاطاً جماعياً – بعد وفاة بروتون.
تتميّز كتابة منصور بتحرّرها من جميع القيود، على مستويي الشكل والثيمات (استيهامات، هوس، أحلام وشبق). وما يزيد سردَها ونثرها الفنّي (ومسرحيَّتَها الوحيدة) تحرّراً أنّها تنفكّ من أَسْرِ نسج الأحداث في تعاقُبٍ خَطِّيٍّ، ضمن خيار سادَ لدى السّرياليين. كما أنّ نصوصها تُبنى على جدليّة العين واليد، ومزيج بين الفنون البصريّة والقوليّة: بدل رصِّ الكلمات وتركيب الجُمل وفقاً للمنطق والمعايير المتواضَع عليها، في وسعنا القول إنّها كانت ترسم بالكلمات لتصنع منها توليفات فنّيّة، من دون أن تنسى تذكيرنا دوماً بأنّ الكتابة والحياة وحدة لا تنفصم. بل حتى على مستوى بناء الجملة، تكاد تقترب جويس منصور من أسلوب التوليف الشّعري، كما هو معمول به – قبل السرياليّين – عند الدادائيّين والمستقبليّين، خصوصاً كما في دعوة الحركة المستقبليّة، في شقّها الإيطاليّ، عبر رائدها مارينيتي، لما يسمىّ بـ «الكلمات المتحرّرة». هنا، يُبنى معمار النص على رصّ الكلمات جنباً إلى جنب، من دون روابط، مع ترك الحرّية للقارئ في تخيّل ما يمكن أن ينتج عن جمعها من صور مثيرة للدهشة؛ بل يحار القارئ أحياناً بين خياري ربط كلمة بالتي تليها أو التي تسبقها. في هذا الصدد، يقول الشاعر السّرياليّ والناقد الفرنسيّ ألان جوفروا، المجايِل لجويس منصور وأحد أصدقائها الحميمين: «نصوص جويس منصور وسُرُودُها تشكّل فيلماً متقطّعاً بوعي حاذق، أفكارها تبسط، تتجوّل كالمسرنم في فضاء الصّفحة». تبدو منجزاتُها الأدبيَّة، حسب الناقد الفرنسيّ بيار تينييل كحوار داخليّ طويل يريد إثارة انتباه أحد ما.
يعتبر مشروع جويس منصور الشعري والسردي والمسرحي اشتغالاً في صلب البرنامج السريالي الذي اختطّه رائده أندريه بروتون لهدم الهوّة بين الحياة والكتابة. ذلك البرنامج الذي ما زال قائماً ضمن مشروعيّة الحلم والحقّ في تحقيقه… الذي يجد جوهره في مقولة بروتون بلغتها التي لا تخلو من نبوءات العرّافين: «سنختزل الفنّ في أبسط تعبيراته، ألا وهو الحب». مقولة تجد صداها في هذا البيت الشعريّ الكثيف الذي يدخل في باب تنظير الشّعر للشّعر، أو ما يسمىّ بالميتا-قصيدة: «اتّبعت الطريق الموازي خلف نسيج العتمات الحريريّ الرّقيق الشّفاف. بين أفخاذ أسلافي ترشق اللّغة العبرانيّة. يبدأ الفنّ حيث تنتهي الرّغبة» (قصيدة «أحاليل ومومياءات»، ضمن ديوان جويس منصور بالعنوان نفسِه ـــ 1969).
تكاد جويس منصور تلخّص صنعتَها في الكتابة بهذه العبارةِ حيث يمتزج الحسّيّ الشهوانيّ بالبصريّ: «الحُبُّ ابن العين» (قصيدة «حرائق عفويّة» من ديوان «الإيماء لسائق الآلات» 1977)، بل إنّ الشاعرة تسير أبعد من ذاك، معطيةً للحرّية – وللفنّ بالتالي كأحد تمظهراتها – دوراً جوهرياً، إن لم يكن الدور الأوحد، في تخليد الإنسان: «سيهزم الإنسان الحُرُّ الموتَ» (من كتاب «عاصمة الجحيم» ـ 1976.] أخيراً، تعرّضت نصوص جويس للانتحال والسّلخ عربياً من قبل بعض شاعرات الحركة النّسويّة، تماماً كما يحدث لبعضهم أن يقلّد النّفس الأدونيسيّ أو الصوفيّ من دون موهبة ولا روحٍ خلَّاقة.
السرطـان
ترجمة: محسن البلاسي
لسنوات عدة لم أفهم أن هذه المرأة كانت تُحتَضَر. كلُّ شيء عنها كان يتأرجح مع المرض المكبوت وتحت ثوبها المتدفق الذي يطفو على جلدها؛ كانت عجوزاً جميلة بمشاعر خَفيَّة، لكن حين أبعدت عينيها عن عيني، وكذلك رأسها المغطى بالقطن، لم أتمكن سوى من رؤية بطنها.
عاشت كلارا وحيدة مع سَنَامِها الوحشي في المنزل الأكبر في القرية بصحبة والدتها، وبعد وفاة والدها كونت دي دوڤيل، أصبح المنزل والحديقة والأشجار وأثاث الماهوجني ملكاً لها.
كنتُ فتى صغيراً أخرس، وكنتُ العامل الوحيد في المنزل. دائماً تجد النساء شخصاً أو شيئاً ما يدعمهنَّ، وكلارا، الغامضة التي لم تخرج ولم ترَ أحداً، اتَّكأت على كتفيّ النحيفين وعايشتني. كنت أعمل طوال اليوم بضمير حَيٍّ. كانت تفتح المصاريع المملوءة بالغبار، وتُصدر صريراً قلقاً مثل كلّ شيء في هذا المنزل، حتَّى الفئران كانت ترتدي القفازات؛ أمَّا أنا، فقمت بتنظيف الأزقة البالية ورعاية الكناري.
كانت كلارا مشغولة أيضاً بأمور عدة. كانت ترتدي ملابسها. سأتذكر دائماً أوَّل مرَّة رأيتُها عارية، كلارا عشيقتي، المرأة الوحيدة التي عرفتها على الإطلاق. كنتُ أشرب الحليب، إحدى يَدَيَّ كانت متكئة على إطار الباب، قدمي مُهيَّأة بالفعل لأخطو الخطوة الأولى إلى الوراء، وعيني في ثقب المفتاح داخل غرفة نومها. كنت أبلغ من العمر اثني عشر عاماً. كانت تنظر إلى نفسها في المرآة، ولم يكن لدي أدنى شك في أنها شعرت بأن عيني الفضوليتين تتأرجحان ببراءة فوق جسدها؛ لحسن الحظ كانت ملابسها اليومية ملقاة على الكرسي، وقد أنقذني منظرها من الإغماء. كانت هي الشيء الخامل والطبيعي الوحيد في الغرفة. انتصب النتوء على ظهرها ورديَّ اللون، يسيطر على جسدها وعلى قدميها العنكبوتيتين، متوِّجاً الثَّديَيْن المستطيلين والرَّدْفَين المطويَّيْن كحصن وعثرة. في الحقيقة، رأيتُ هذا السَّنام فقط رغم أنني أبصرتُ الباقي في الأسابيع البرِّيَّة التي تلت تلك النظرة الأولى، إلا أن الحَدَبَة كانت اكتشافي العظيم. تركت كلارا المرآة، وارتدت ملابسها ببطء أمامي. لم تكن متواضعة، بل كانت تبتسم ورأسها يتمايل على صدرها؛ وأنا شعرت بالسعادة في التبرير الواضح لغضبها وخوفي. لم أغادر المنزل منذ ذلك اليوم الذي لا يُنسى، رغم أنه مُشبَعٌ برائحة الكبريت القوية. أحببتُ السَّنَام، وعشتُ حوله فقط. اكتشفت كلارا الحُبَّ في الوقت نفسه الذي اكتشفته أنا فيه. داعبتها بخوف، ولاحظت هي بفخر دلائل هذياني. استمعت إلى الصوت المكتوم الذي يصرخ بداخلي، ذلك الصوت غير القادر على التعبير عن اعترافاته الحزينة. لقد فهمتني دون كلمات، وكنتُ على استعداد لفعل أي شيء لإرضائها؛ عابدة الأوثان تتلوى حول الحَدَبَة. سألتني ذات يوم: «هل أنت خائف؟ هل ما زلتَ طفلاً؟». بابتزاز! كنتُ أداعب جبهتها وشعرها الناعم، ولمستُ ثدييها اللذين تجعدا تحت أصابعي، وقبَّلتُ عبوس فمها المتورم، لكنني بكيتُ بانزعاج، لأنها رفضت أن ألمس حَدَبَتَهَا. «لماذا تعاقبني؟ كنتُ سعيداً جداً، سعيداً جداً». عندما قرأتُ يأسي عبر دموعي، أمرتُ نفسي بقسوة: «إذن، كن رجلاً». ثمَّ أغمضتْ عينيها، وعرضتْ نفسَها أمامها. ألقيتُ بنفسي على السرير خوفاً، وأسناني تثرثر ونظراتي تنجرف إلى الأروقة؛ كنتُ مجرَّد كوكب بارد. فأكثر الآلام التي لا تُطاق لا صوت لها. عودت نفسي على جُبني، وعذَّبتُ نفسي، وكنتُ أكل كل يوم أمل مواساتي الباطل.
استحوذت على الكرب كاملاً، ولم أعد أجرؤ على الاقتراب من سيدتي وتيقنت دائماً أن الجسد كان مستلقياً على الأريكة مع تلك اللحوم كلها على ظهره، وعانيت من عدم القدرة على امتلاكه. كان المنزل مملوءاً برائحة اكتشاف عش لأي اختيار. كانت كلارا تُحتَضَر، يلتهمها سَنَامُها، والمنزل ينزلق بعدها في مستنقع الحياة الآخرة دون أي جهد للتشبث بالأرض. لقد حلمت برسم القبة العملاقة بأسناني، وفرك نفسي على سطحها المصقول والمغادرة وذراعي مملوءة بهذا القبر الساكن، نحو المدينة التي تبدأ فيها الحياة؛ نحو بابل.
في المساء، قبل الذهاب إلى الفراش، وصفت لي كلارا الحياة في بابل، ولم أغمض عينيَّ فيها إلَّا متأخّراً بسبب الشوارع المملوءة بالدخان، والرياح الجليدية، والعذراوات، والبغايا اللواتي كن جميلات كلّهنَّ، وبالطبع تلك الحدباء.
عاشت عدة سنوات في مدينة أحلامي، مع والدها وخالتها العجوز حتَّى وفاة الأول واختفاء الثانية. ثمَّ بمفردها حتَّى أصابها ورم صغير بالكتف. نفت نفسها طواعية إلى الريف، لتكرّس نفسها بالكامل للأدوية وثقافة مرضها. عندها، بدأ النتوء ينمو بشكل جديّ، حاولت كلارا في البداية إخفاءه، كانت خجولة من الانتفاخ الغاضب في لحمها، وقلقة على صحتها؛ ثم بدأت تحبُّ هذه الرمال المتحركة، مع العلم أنه تحت جلدها كان هناك لغز ينمو في الصمت، يتغذى على دمها. لغز مستقر.
قبل اكتشافي للمرأة بالكامل، رأيتُ في كلارا عشيقة متواضعة فقط، مجنونة بقبح عدواني، لأنني كنتُ قد اعتمدت على نفسي، وكنتُ بعد، لم أزل ملفوفاً بشال الطفولة الأعمى، غير حسّاس للجمال الذي ازدهر أمام عيني. اعتقدت أنني أفتقر إلى الخيال في الثالثة عشرة من عمري، كنتُ ما زلت غير قادر على إرضاء كلارا، رغم أنني تعرّضت للتعذيب بسبب رغبتي الشرسة في الحَدَبَة. استيقظتُ ذات صباح لأجد جسدي يستحم بنوع من العَرَق الودود؛ بدا جذعي غير مناسب لرقبتي، وكنتُ أرمش وقضيبي متيبس على جانبي.
ثم أدركت كلارا على الفور طبيعة مرضي، وكنتُ سعيداً أخيراً أن رغبتي التي هي مثل سمكة تسبح إلى سطح الماء، قد ظهرت أخيراً. قالت لي: «تنفس بعمق، لا تقلق، سأخبرك عندما يحين الوقت». كان السَّنَام يتأمل خيانتي من أعلى جسدها.
كلارا، النحيفة والمضيئة بجلدها تحت شدَّة ارتجاج حَدَبَتِهَا، أخذتْني مثل طائر بين أطرافها كأجنحة الزيز، وطحنتني. هكذا أصبحتُ بعد أن اختنقت من السعادة؛ المالك المثالي. ليس هناك شك في أن الرغبة توجد بشكل مستقل عن الكائنات؛ اليوم بعد أن أصبحت عجوزاً ولم أعد آمل في تذكُّر ورؤية حُبِّي المراهق الكبير، أعيش وأحيا كل لحظة من شعوري عبر مواصلة استكشافاتي المثيرة وحدها، لا أحد يستطيع أن يفهم شعور العشق الذي أثاره في هذا الصندوق المختوم، هذا الطفيلي؛ وإذا أعادها القدر إلى طريقي، لا أعرف ما هو الجنون الذي سأكون قادراً عليه. رضخت كلارا لشغفي، مندهشة قليلاً من عنف حماسي، كانت غيورة قليلاً من ذلك الجزء من نفسها الذي فضَّلتُهُ أنا على أي جزء آخر. أصبحت أرقّ يوماً بعد يوم، وكبر الورم. يداها طويلتان ورقيقتان كالكروم، تضربان الهواء بإيماءات متشنجة ومجنونة، وكان وجهها لا يزال مخفيَّاً، بينما تنثي رقبتها تحت الوزن الزائد، وعيناها تتدحرجان إلى الوراء، في محاولة لمعرفة ما يجري أمامها. أيقظني غضبي الفحل أمام امتداد الخانوق البرّي.
كل لحظة في الحياة عشناها معاً. استلقيت على سريرها، إحدى يدي كانت مثل التاج على النتوء؛ أكلتُ معها على المائدة الكبيرة، قطعتُ ماء استحمامها بجسد طفل مريض مصاب بتشريح سيئ. كانت كلارا سعيدة ترتدي ألواناً زاهية؛ مبتسمة – هي التي لم تبتسم من قبل – وقد انحنى رأسها بعناية، عرضت عليَّ نفسها دون أن تطلب مني شيئاً.
لكن هذا أيضاً لم يدم طويلاً. ورغم سعادة كلارا، ماتت. كانت واحدة من تلك المخلوقات التي صنعت لتعيش في الظلام، دون هواء أو إشباع من أي نوع، في خزنة بالبنك أو غرفة باردة أو جَرَّة. إذ كانت غريبة الأطوار وغير سعيدة، كان يمكن أن تعيش لأنها لم تفكر إلا في النضال، فكانت سعيدة، لأنها اضطرت إلى الاختفاء، حين كانت الحدبة تتفتح. كان الطقس الحار مناسباً للحَدَبَة تماماً، لدرجة أن كلارا سمحت له بالتهامها دون أن تدرك ذلك.
الحَدَبَة القديرة التي لا تتغيّر كالصخرة، كانت بالنسبة إلي رمزاً للحياة الأبدية؛ هذه الصخرة عاشت وحرمتني من كل إحساس بالوجود الأرضي. عبثاً رأيتُ الموت على وجه عشيقة شفّافة، كدتُ أتجاهلها، كنتُ مهووساً جداً بالحَدَبَة، لدرجة الهذيان الذي جعلني لا أفكر في إنقاذ المرأة. لم أستطع أن أصدِّق أنه بموت كلارا فإن كلمة النهاية ستسجل في أي نقطة من طريقي؛ كان النتوء حياتي، وإذا كانت كلارا، ذلك الظل الباهت، تتلمس طريقها نحو الزوال، فلن أفتقدها، لأن حُبِّي كان مكتفياً ذاتياً. ولكن، بعد ذلك جاءت الكارثة. أخذ الموت يصف زخارف الأرابيسك المتقلبة، واقترب، واقترب أكثر حتَّى ذلك اليوم الذي وجدتُ فيه كلارا ملقاة على بطنها، ووجهها مدفون في دمية دُبِّ، ملقاة على سريرها بستائر مخملية. لم أكن خائفاً، لأن النتوء بدا أكثر حيوية من المعتاد؛ وشعرت بقلب ينبض تحت غشائه، ولم يمسني أيُّ اتصال مميت آخر غير ذلك. كانت تتنفس بصعوبة. تأرجح الضوء على إيقاع القارب. وبدت المرأة وكأنها دمية ساخرة تحت شعرها المجعد جداً وعينيها البطيئتين وقصر نظرها الذي كشط وجهي من قبل. دون شفقة، سحبت قميصها فوق رأسها. عرياناً تحت السراج، اهتز السَّنَام فوضعت يدي بثقلها كله على قمته. كان السنام يحترق. ماتت كلارا حوالى الساعة الرابعة صباحاً. الذكرى التي أحتفظ بها في تلك الليلة كثيفة بشكل غير مسبوق؛ حواف ضباب حولي، ترسخت وبشدة في بشرتي، كنتُ مجنوناً. انتصرت الحَدَبَة دون أن تنبس ببنت شفة. مرت موجة من الظل فوق الجسد، وتوقفت حشرجة الموت.
فجأة لم تعد كلارا موجودة. اكتشفت بحنان وجه الميت. لم أغمض عينيها، لأنني أحببت تعابير وجهها، لكنني ارتديتُ قُبَّعة مدينتها المصنعة من ريش الغراب المخمليّ، وبسطت الملاءات على ساقيها. لا يستطيع الأخرس أن يصرخ طلباً للمساعدة، لذلك لم أبكِ، لكن قلبي خفق في صدري، ويَدَيَّ كانتا ترتعشان. كانت الحدبة تبرد، وتراجعت قوتها المغناطيسية على قاعدتها. لقد وضعت راحتي عليها، وقبلتها، ولعقتُ جروحها، لكنها ابتعدت في لامبالاة قاتلة بسبب البراز. قفزت على السرير المحاربة عدوِّي. خلال هذا التعرُّق حفرتُ في عنقي، راغباً في حفر يأسي على جدران روحها؛ كان الامتلاك الكامل المأمول فيه مجرد غبار في فمي: لم يعد يعرفني السَّنَام. ملعوناً، ولاهثاً من الغضب، كنتُ أتجول في أنحاء المنزل جميعها طوال اليوم. كان الشيطان السمين يسكر بالقرب من السرير وأضافت الساعة تفاهات صوته إلى آلامي، وتنهد السَّنَام مثل امرأة سمينة بعد مجهود. مع حلول المساء، سادت طبيعتي الخجولة والمستاءة: أخذتُ سين السيد لوكوميه، وهاجمتُ السَّنام الطفيلي دون تفكير. غرق النصل مع صوت شفط؛ حلَّقتُ مع اللون الأحمر، ولا تزال الحَدَبَة تتشبَّث بكتف ضحيتها مثل علقة وحشية، فَتَنَتْنِي، وأصابتني بالدوار. لقد شعرت برغبة بعض الرجال تجاه النساء ذوات الرذيلة المبهجة. اعتقدت أنني لا أقاوم. بخيبة أمل قمتُ بتمزيق اللاصق المطاطي، مندهشاً من مظهره المهيب تحت مطر الدم، لكنني لم أكن قلقاً بأي حال من عواقب إيماءتي. في النهاية كان عليّ الاستسلام. طاف بخار شفاف بين عيني، وعبر الشكل الملقى على السرير، لم أعد أتطلع إلى أي شيء آخر غير النوم، لأن جسدي أيضاً لم يكن أكثر من جثّة، جثّة لا صوت لها، لكنها لا تزال تتنفَّس. استلقيت في البركة التي كانت السجادة وكبَّرتُ كثيراً. أيقظتني الشرطة. فحص الطبيب كلارا. فتش بطنها المسكين بملاقطه، متجاهلاً النتوء المتفجر، وتجاهلني أيضاً. أعلنت الصحف أن عشيقته تُوفِّيت بالسرطان. لم يهتم بي أحد رغم شهادة الشيطان غير المرغوبة؛ تم بيع المنزل، ودُفنت الحَدَبَة. منذ ذلك الحين عشتُ بسلام مع ألمي، وانفكت عقدة لساني أخيراً، وعثرتُ على السَّلْطَعُون الصغير بالقرب من الجثة بشكل غير مفهوم. أشعر في بعض الأيام وكأنه يشبهني.
* مِنْ مجلَّد أعمالها النثرية الكاملة الصادرة حديثاً عن «منشورات المتوسط» في ميلانو، بعنوان «قصص مؤذية» للمترجِم نفسِه
ملحق “كلمات”