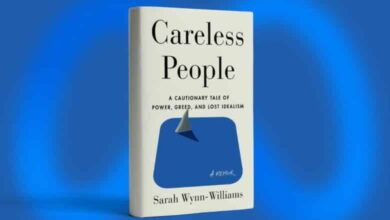رحلة الخروج من «جورة الهم»/ حسام جزماتي

لا تأتي سخونة هذا الكتاب من صدوره الطازج عن «مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر» فقط، بل أساساً من الحرارة التي كُتبت بها سيرة تطور وعي مؤلفه، محمد أمير ناشر النعم، المتناثرة بين فصول كتابه الذي حمل عنوان «جورة الهم: سوريا في زمن الأسد». ما يغري باستلالها نموذجاً عن تشكّل موقف كثير من السوريين من ذلك العهد، منذ أن أسفر عن وجهه في أواخر السبعينات وحتى اضطرهم إلى الخروج من بلادهم بعد الثورة وتوحشه في قمعها. لا سيما وأن أجزاء الكتاب هذه هي الأمتع، وإن لم تكن الأكثر عمقاً أو ثقافة أو حفراً لغوياً.
تلقفت «منظمة طلائع البعث» المؤلف منذ دخوله المدرسة، كما هي حال أبناء جيله والأجيال اللاحقة، بلباسها الموحد المكوّن من الصدرية البيج الغامقة والسيدارة الكحلية المثلثة والفولار البرتقالي الممهور بشعار المنظمة. وسيترك غسيل الدماغ أثره في السنوات الابتدائية حين يردد الأطفال، أثناء خروجهم من المدرسة، «لا إله إلا الله، والأسد حبيب الله» ضاحكين مقتنعين. حتى يفاجأ الراوي، في عام 1979، بمظاهرات تهتف ضد حافظ الأسد وتقطع حركة المرور بالدواليب المحروقة، وتقابلها «الوحدات الخاصة» بإطلاق الرصاص الحي الذي كاد أن يصيبه. قبل أن تنفذ إحدى هذه الوحدات ما سيدخل في ذاكرة الكاتب/ الطفل بوصف «مجزرة» في حيّ «المشارقة» المعروف في مدينته حلب.
بمزيج من هذا وذاك؛ الرصاص العشوائي والمجازر المنظمة، ستتمكن السلطة من إعادة سيطرتها ووأد التمرد في عام 1982 الذي يسميه المؤلف «عام السَّوق إلى المسيرات» لكثرة ما فرضت فيه أجهزة النظام على الناس من الخروج في مسيرات تأييد صاحب المسيرة والولاء للقائد الرمز. دون أن يعي طلاب السادس الابتدائي، وربما من هم أكبر أيضاً، هدف المسيرة ولا أبعاد رمزها. وبمعيّة الخوف الذي سيطر على البلاد كان على الصغار، والبالغين بالطبع، ألا يتخلفوا عن أي مسيرة في مناسبة ميلاد حزب البعث الحاكم، أو استيلائه على السلطة، أو إمساك قائد المسيرة بها، أو حربه التي أسماها تحريرية. فضلاً عن عيد الجلاء والشهداء والعمال… إلخ، في احتفالات مصنّعة لا تتوقف طيلة العام، يُجبَر فيها المسيَّرون على حمل الأعلام وصور القائد ولافتات تخليده، ناهيك عن الدبكات والرقص والهتافات: «حيِّدوا نحن البعثية حيِّدوا… حافظ أسد بعد الله منعبدوا»، تحت طائلة الاشتباه والتعرض للمساءلة التي لا يضمن أحد نتيجتها مع التغول الأمني وانتشار الحديث عن سجن تدمر سراً.
بالانتقال إلى المرحلة الإعدادية سيخضع الطلاب لدرجة أعلى من العسكرة تجلت في البدلات الزيتية المشتقة من ملابس الجيش وقتئذ، وفي دخول مادة «الفتوّة» ومدرّبها، بما تحويه من تأهيل خاص باليافعين، في المقررات الدراسية. في الحصة الأولى لهذه المادة ستدخل إلى قاموس المؤلف كلمة «المعلّم»، بالتزامن مع شيوعها وتغلغل عقليتها في البلاد، عندما طالبَ المدرّب أن ينادَى بها، أو بلفظة «سيدي»، تمييزاً له عن باقي المعلمين الذين يحملون لقب «أستاذ» المرذول في القوات المسلحة. لن يمرّ التنبيه إلا بصدمة لدى الطلاب عندما تلقى عريفهم الجذل صفعة صاعقة بعد أن خاطب المدرب الخشن بتلك الكلمة المحرّمة.
في المرحلة الثانوية وضع الكاتب نفسه في مركز الاشتباه بدخوله مدرسة «الخسروية» الشرعية وارتدائه الجبّة والعمامة، عندما كان البحث عن فلول «الإخوان المسلمين» أو أجيالهم الناشئة المفترضة هاجس الأجهزة الأمنية في عموم البلاد، وفي حلب ومثيلاتها من المدن على وجه الخصوص. فقد بدا هذا الشيخ الشاب صيداً محتملاً لأحد المخبرين الذي صار يسأله، مستدرجاً، عن رأيه في كتب حسن البنا وسعيد حوى، قبل أن يعود بخفّي حنين نتيجة المراوغة.
في الحياة العملية استقر المؤلف في إدارة دار الأيتام. وهو الوضع الذي وجد فيه نفسه عند قيام الثورة وتحولها إلى مسلحة، عندما اشتدت الاشتباكات بين فرع «المخابرات الجوية» الملاصق للدار وبين مقاتلين معارضين. وهنا يصف عملية إجلاء الطلاب من هذا المكان الحساس بعد تعرضهم لمخاطر متكررة تُوِّجت بقذيفة أحد جدران مبنى منامتهم لكنها لم تنفجر لحسن الحظ. ولا يفوته أن يذكر بدقة أسماء المشرفين والمشرفات الذين نفذوا بإخلاص عملية نقل الطلاب والأضابير والوثائق في نقلة كان الأمل أن تكون قصيرة لكنها استمرت سنوات.
من جهة أخرى كان ناشر النعم يقيم في مدينة أريحا بمحافظة إدلب. ومن هناك ينقل مشاهدات أقسى دفعته أخيراً إلى أن يقود أسرته في رحلة المنفى، كما سبق أن رافق باصات طلابه. فمثلاً اعتادت قوات الجيش المتمركزة على أطراف أريحا قصف سوقها الشعبي بقذائف الهاون كل مدة، ولا سيما في أيام البازار واحتشاد الناس. ومرة أصابت إحداها صديقه القصاب في محله في سوق الهال. ولما أسرع ولداه لإسعافه بسيارة إلى المشفى الوطني بإدلب، بعد تدمير مشافي أريحا سابقاً، أوقفهم حاجز للجيش وأمرهم بالجلوس في الشارع لساعات راقب فيها الشابان أباهما وهو ينزف دمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وهنا اعتقل الجنود ولديه والسائق لأسبوع عادوا منه مكسوري الأيدي والأرجل مهشمي الأضلاع.
غير أن التجربة الحاسمة كانت في عيد الأضحى من عام 2012، عندما قرر الراوي وأسرته أن الوقت ربما كان مناسباً لقطاف محصولهم من الزيتون قبل أن تفاجئهم رصاصات الجيش التي أصرّت على ملاحقتهم، وسواهم، بين أشجار الأرض ومرتفعاتها ومنحدراتها حتى أصابت ابنه الذي لم يمكن إسعافه إلا في عيادة مرتجلة في قبو معصرة قديمة.
مثل قائد متخصص في الانسحاب فقط، كما يقول الكاتب ساخراً، قرر أن يتقدّم قافلة أسرته في طريق الخروج من البلاد. وبعد النجاح في اجتياز حواجز الجيش والأمن والشبّيحة وصلت الأسرة إلى المطار. وعندما شقت الطائرة طريقها بين أعمدة الحطام والدخان وهياكل البلاد المنهارة وكتلها الضخمة المتساقطة تدفق في صدره تيار عذب من الرضى. وحين حطّت في القاهرة مشى حراً طليقاً لأول مرة. وقرر: «يجب أن أصرخ. أترنم. أنشد. أغنّي. أضحك. أقهقه. أكتب. وهذا ما عملته في هذا الكتاب».
تلفزيون سوريا