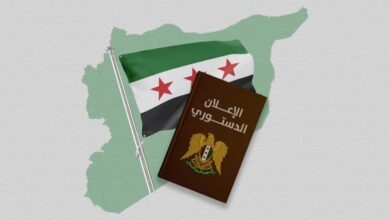سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 18 كانون الثاني 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————————–
عن ضرورة «الجهاد» ضد النفس الأمّارة بالسحر!/ حازم السيد
حاجتنا لمقاربة تاريخية لانهيار النظام السوري وحدود الوطنية الديمقراطية الميلودرامية
18-01-2025
1.إن كان لأعمال مارسيل غوشيه أهمية كبيرة في تحليل ونقد الحداثة وفردانيتها وتطرف المشروع النيوليبرالي، فإن الأفق الذي يحاول أن يمضي إليه لا يخلو من سقطات، وكأن القومية، مفرز الحداثة الذي لا يخلو من شحنة سحرية، هي الحل لعودة السحر إلى العالم، أو كأن المطلوب هو عودة السحر إلى العالم.
2.لا بد من التذكير أن النزعة القومية هي الفأر الذي تَمخّضته الحداثة، وأنه فأر خطير ومُدمّر، وقد يودي بأرواح الملايين، وضمائر عشرات الملايين، كما حدث في الحربين العالميتين، وفي الكثير من الحروب القومية التافهة.
عندما سقط النظام، شعرتُ بحاجة هائلة إلى الخروج ولقاء سوريين آخرين كي يؤكد لي هواءُ الشارع البارد وعيونهم الذاهلة أن ما حدث حقيقي، وأن الأبد الأسدي قد انتهى إلى غير رجعة. لم يُغادرني ذلك الذهول لأيام طويلة، وكنتُ عاجزاً عن النوم أو التوقف عن الحركة. بدى ما حدث شديد «السحرية»، فقد انهارت المنظومة العسكرية كقلعة رملية تافهة، وبدى وكأن قائد ميليشيات الشمال الإسلامية وكل عناصرها «بتوع تنمية بشرية»، بالنظر إلى انضباطهم وقدرتهم على إدارة اللحظة وتحدياتها الأمنية والعسكرية. بدى وكأن هذه اللحظة قد انبثقت من آلة زمن، عادت بنا إلى الثورة السورية في لحظاتها الشعبية الظافرة منتصف 2012، كي تُنسينا كل آلام سنوات الجلجلة التي تلتها.
رغم أنني قضيت السنوات الخمس الأخيرة في علاج سلوكي وفلسفي مكثّف كي أتمكن من العيش في عالم منزوع السحر، لم أُشفَ حتى اليوم من سحرية تلك اللحظة، ولا أعتقد أنني سأشفى قريباً، ولكنني أعتقد أيضاً أن الوقت قد حان كي نبدأ التفكير ضد الذات وأهوائها، ضد السحر وسطوته، وأن نبدأ «الجهاد ضد النفس الأمّارة بالسحر»، إن استلهمنا واحدة من مقولات المعلم الياس مرقص.
السوريون وعوالمهم منزوعةُ السحر
أطلق عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر مقولة نزع السحر لتوصيف تخابي سطوة الرؤية السحرية، الدينية والأسطورية، لفهم العالم أمام رؤى «عقلانية»، نقدية ووضعية وتاريخانية، تستلهم في مَقولاتُها فتوحات العلم الحديث والمكتسبات التقنية الهائلة وبعض تراث فلاسفة الأنوار. وهي المقولة نفسها التي استعادها الفرنسي مارسيل غوشيه1 في كتاب يحمل عنوانه هذه المقولة، وفي مجمل عمله النقدي عن عمق «الخروج من الدين» الذي تعيشه المجتمعات الغربية، عن علاقة ذلك بالديمقراطية، وعن هذا الخروج بوصفه واحداً من التحديات الكبرى، وأحد أكبر أسباب «البؤس الفرنسي» والبؤس الغربي عموماً، والمدخل الأمثل لفهم حدود الفردانية والحداثة وبخاصة في شكلها النيوليبرالي. في السياق السوري، يستعيد ياسين الحاج صالح المعنى الأول، الفيبري، لهذه المقولة ويحاول استخدامها لمقاربة أسئلة الحداثة والإسلام السياسي، ومحاولة فهم بعض الظواهر المعاصرة، كانتشار نظريات المؤامرة والحقائق البديلة والمقاربات الثقافوية بوصفها محاولات بائسة لـ«إعادة بث السحر في العالم».
هي بالمختصر مقولةٌ شديدة الخصوبة وشديدة الراهنية، وقد يحتاج فهمها إلى قراءة الكثير من الأعمال النقدية، للكتّاب سابقي الذكر ولغيرهم، ولكن اللجوء إلى طقوس عيد الميلاد قد يسهّل فهم قوة هذه المقولة وبعض معانيها، فاللحظة التي يكتشف فيها الأطفال، المعتادون على طقوس عيد الميلاد، أن بابا نويل مجرد كذبة، يمكن أن تشكل مجازاً معقولاً للحظة نزع السحر عن العالم بوصفها صدمة وجدانية عميقة، ودعوة وقحة لتغيير الرؤية التي قاربنا بها العالم لسنوات طويلة.
إن كان المثال الأول يسمح بفهم العُمق الوجداني للمقولة دون أن يسمح بفهم معانيها، فإن ما عاشه الكثير من السوريين، من أبناء الطبقات الوسطى، ممن تعاطفوا مع الثورة وشاركوا فيها قبل أن يهربوا من بلادهم طالبين اللجوء في القارة الأوروبية، يبدو تجسيداً تاريخياً شديد العمق لمعاني هذه المقولة. فَقَدَ السوريون كل أساطيرهم، وكل المصادر القادرة على مقاربة الواقع وإعطائه معنىً متماسكاً، فَهُم في البداية متعلمون عصريون، يشتركون مع الكثير من الغربيين في عدم قدرتهم على التدين وتحويل الدين إلى الركيزة الأولى لرؤيتهم للعالم ومصدر بث المعنى. من جهة أخرى، وعلى اعتبار أن الانتماء الوطني هو ما تمّخضته الحداثة في محاولتها لتعويض غياب السحر2، وأن الثورة التي شارك بها هؤلاء السوريين، كي تلدَ لهم وطناً، لم تلق إلا مصائر مذهلة في عنفها وعبثيّتها، فقدت هذه المحاولةُ معناها، بل وبدى أن السوريين لم يفقدوا القدرة على الإيمان بالوطن وحسب، وإنما فقدوا الوطن بمجمله.
اللجوء إلى أوروبا الذي وعد كثيرين باستبدال أوطانهم بإمكانية الانتماء إلى «الحضارة الغربية»، التي تُجسِّد أهم ما جاد به التاريخ، وإلى واحدة من أقوى ديناميات بث المعنى في العالم، بدا شديدَ البهوت أيضاً، وبخاصة في العقد الماضي الذي شهد فقدان مقولة «الغرب» لجاذبيتها وانكشاف عمقها الاستعماري والعنصري. فقدت قطاعات واسعة إثرَ ذلك إيمانها بالقدرة على الانتماء إلى هذه الحضارة، بل وبهذه الحضارة نفسها، بعد أن لامسوا فيها الكثير من «البلادة» والبيروقراطية والأنانية، وبعد أن أدركوا أن الانتماء لا يمكن شراؤه ببطاقة مصرفية، وأن الكثير من شروط العيش الطيب التي اعتادوا عليها في مجتمعاتهم الفقيرة والمتخلفة، قد باتت مفقودة في هذه المجتمعات الحديثة المترفة. لا بد في هذا السياق من التأكيد على أن حياتهم في الغرب قد منحتهم الكثير من الرفاه والأمان والطمأنينة على مستقبل أطفالهم، ولكنها لم تساعدهم على استعادة الإيمان، بالدين أو الوطن أو الحضارة، بل وزادت عزلتهم وتعقيد حيواتهم العائلية، ليفقدَ بعضهم إيمانه بالحب والعائلة أيضاً. بالمختصر، اكتشف الكثير من السوريين الأوروبيين في مشوارهم العوليسي هذا أن لا معنى متيناً لهذا العالم، وأن لا حدود للهشاشة.
لأيام قليلة مضت كانت النسخة السورية من العالم العدمي منزوع السحر أكثر نُسَخه بؤساً، وكان السوريون تذكيراً بما عرفه اليهود في النصف الأول من القرن الماضي، أو ذلك الذي لا زال الفلسطينيون يتذوقون مرارته منذ نكبتهم. ولكن عملية الـ11 يوماً وقائدها أحمد الشرع باغتوا السوريين في نهاية العام، كبابا نويل، بهدية انهيار الأبد السوري، ليستعيد العالم كل سحره في عيونهم.
تَوازنُ رسائل قيادة الهيئة والانضباط الكبير نسبياً لمقاتليها، تواضعُ انتهاكاتهم واعتراف بطانة النظام السريع بهزيمتهم ورفضها للمقاومة، تصريحات الشرع البراغماتية وتصريحات قيادة قسد، عدا عن الوفود الدبلوماسية التي لا تتوقف عن التدفق إلى العاصمة السورية، تجتمع كمؤشرات على لحظة سياسية كبرى تطوي الماضي بكل تعقيداته وتبدأ صفحة جديدة بكل ما يقتضيه هذا التعبير من حُسن نية. بل وتبدو هذه اللحظة وكأنها صفحة جديدة بالمعنى التاريخي للكلمة، تعود بالمجتمع السوري إلى لحظات بداية النهضة، لتَحكمهم سلطات إسلامية ماضوية متواضعة القوة، بكل ما يفتح عليه ذلك من احتمالات، وبكل ما يقتضيه من سياسة.
الخطاب الوطني الديمقراطي، عودٌ على بدء؟
نرغب جميعاً تصديق ذلك، وهو ما تُظهره مقالات الرأي التي استعادت زخمها اليوم، حيث يضج الفضاء العام السوري بأصوات مسكونة بالأمل والرغبة بالعمل وبدء صفحة جديدة. برهان غليون نفسه، الذي كان غارقاً في التشاؤم التاريخي في كتابه الأخير سؤال المصير، يستعيدُ اليوم الكثير من تفاؤله وهو ما يعبر عنه في رؤيته «لمسار سوريا الجديدة» على تلفزيون العربي.
يبدو غليون بديمقراطيته الوطنية رجلَ المرحلة، فإن لم تتمكن كتبه الكبرى، كـ بيان من أجل الديمقراطية والمحنة العربية: الدولة ضد الأمة ومجتمع النخبة وفي الشعب والنخبة وغيرها، من مساعدتنا على «إسقاط النظام»، فإنها تبدو اليوم وكأنها الأقدر على تغذية فكرنا من أجل خوض معركة «الانتقال الديمقراطي»، فالإسلامُ السياسي بات في السلطة، ولم يعد يوجد قبالته أي تهديد عسكري وازن وقادر على سلبه السلطة كما حدث سابقاً في الجزائر وغزة ومصر، وهو بدوره لا يملك إلا بعض السلاح الخفيف والمتوسط الذي خاض به الحرب، والكثير من الحذر الغربي والإقليمي، ما قد يسمح له بالاستئثار بالسلطة، دون أن يعني ذلك قدرته على إعادة التأسيس لأبدٍ جديد أو تفادي السياسة في علاقته مع الغرب ومع مجتمعاته المحلية.
تجربةُ الثورة والحرب التي خاضها أبناء هذا التيار، والتحولات الكبرى التي عرفها في الخطاب والممارسة، بما انتهى بأكثر أطرافه تَشدُّداً إلى قبول تلقيح إسلاميته بخطاب وطني وثوري بل ونهضوي، كما يتجلى في بعض تصريحات الجولاني أحمد الشرع، تأتي لتزيد من احتمالات السياسة. العلمانيون والتنويريون، خصومُ الوطنيين الديمقراطيين وأبناءُ «مجتمعُ النخبة»، الذي أفرزته الدولة ضد الأمة، فقدوا دولتهم، ولا يوجد ما يُبشّر بأن خسائرهم ستتوقف عن التتالي أو أن خطابهم سيتوقف عن فقدان جاذبيته.
يسمح ذلك لبرهان غليون بالزهو والتفاؤل ليشْرَعَ في الحديث عن «عودة الشعب»، وضرورة «تجاوز الماضي»، بل باستعادة مقولة «الشعب السوري العظيم» والمشاركة في غناء «أرفع راسك فوق»، ليبدو شديد التمسّك بنسخته الميلودرامية من الوطنية الديمقراطية، شديدةِ القناعة بحتمية مستقبل تُعانق فيه سوريا «الروح الأموية» التي طالما تاهت عنها، تمتلك الكثير من الأيام الجميلة أمامها، وتقول إن أغلب النخب السورية «الأموية» ترغب بنسيان نصف قرن من تاريخها، واعتباره صفحة استثنائية عنيفة كان آل الأسد مصدر شرورها، ولا بد من طيّها، على الطريقة الألمانية، عبر التعويل على أموال الجيران العرب ربما، وعبر الكثير من التسامح والقليل من سياسات المُصالحة والعدالة الانتقالية، في مرحلة انتقالية لا بد منها للوصول إلى الديمقراطية.
حايد حايد، على سبيل المثال، يعتقد بأن السوريين قد قاموا بدورهم في إسقاط النظام وأن على «المجتمع الدولي وحلفائه الإقليميين القيام بدورهم… من خلال ضمان أن تكون هذه الفترة الانتقالية شاملة وديمقراطية وشفافة»، كي تكون هذه اللحظة «فرصة تاريخية لسوريا يجب أن لا تضيع». يبدو كرم نشار في مقالته «أيها الديمقراطيون السوريون، هذه لحظتنا!» أكثر حذراً ولكن ذلك لا يمنعه من الدعوة، على خطى فرانز فانون، إلى الانخراط في الحياة الفاعلة كما تنفتح أمامنا بكل تناقضاتها ومصاعبها». صادق عبد الرحمن يذهب إلى تفكير أكثر عيانية في مقالته «ما الذي يمكننا الدفاع عنه في سوريا اليوم؟»، ليؤكد بأن «حرية التعبير والانتظام السياسي في سوريا ليست ترفاً سياسياً يمكن تأجيله، بل هي الشرطُ الشارطُ لبناء بلد جديد أفضل».
تُعطي هذه المقالات لمحة عن عودة الخطاب الوطني الديمقراطي، وتبدو أقرب إلى ترجمة عملية لمقولات هذا الخطاب، وهو ما يوحي بدينامية إيجابية وبرغبة ببداية جديدة، يعمل فيها الديمقراطيون على خطابهم ومؤسساتهم للتواصل مع المجتمع والدفع تجاه انتقال ديمقراطي فعّال، وهو ما يبدو شديد البداهة في هذه اللحظة الأمّارة بالسحر. بالمقابل، في سياسوية هذه المقالات وهَمِّها العملي ما يستوجب التوقف عنده. وكذلك انتعاشُ منظومة الرأي والمنتديات السياسية، المتوقع والواجب والإيجابي، والتي توحي بأننا مواطنون وأصحاب رأي، وأن لهذا الرأي وزناً، وأن الصراع الرئيسي في الفضاء العام السوري يجب أن يكون على تحويل بعض المسائل إلى «قضية رأي عام»، تستوجبُ التوقف عندها بينما نتذكّر أن مقولات المواطن والرأي العام والفضاء العام ليست مفردات ناجزة وبداهات وطنية، وإنما عناوين لمعارك طويلة يجب أن نخوضها.
من جهة أخرى، فَشلُ الخطاب الوطني الديمقراطي في خوض تجربة الثورة، وانهيارُهُ في لحظة الحرب، وتاريخيةُ اللحظة الراهنة وقدرتُها على التحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الوطنية الديمقراطية على التحول إلى سياسة، أمورٌ يجب أن ألا تسمحَ لمنظومة الرأي ومقالاته بالسيطرة على المشهد فحسب، وإنما أن تدعونا إلى أن «نكتب ببطء» وبطموح نظري، بل وفلسفي، في مقولات الوطنية الديمقراطية واحتمالات تجديدها.
يُقدِّمُ ياسين الحاج صالح اشتغالاً نقدياً شديد الأهمية لخطاب الوطنية الديمقراطية الميلودرامية، بل ويتحدث في واحدة من مقالاته عن «نهاية نموذج الوطنية الديمقراطية؟» كـ«نموذج مرشد» للعمل السياسي، بعد استفحال «الأثر الاستقطابي المديد لخصخصة الدولة مشفوعاً بكلٍ من نزع وطنية الأكثرية وديمقراطية الأقليات يضعنا كلياً خارج النموذج الوطني الديمقراطي للسياسة» دون أن يعني ذلك أن هذا النموذج قد مات «موتاً طييعياً» فقد مات «بالحرب، بقوة السلاح المتفوق».
قبل هذا الإعلان، قَدَّمَ ياسين في العديد من المقالات، كمقال «تغيير المجتمع: ثلاث تصورات وثلاث تيارات» أو مقال «أزمة الديمقراطيين السوريين»، الكثير من النقد العياني الدقيق للخطاب الوطني الديمقراطي عموماً، لينتقد تعبوية الخطاب، سياسويته واختزاليته، وعجزه عن التقاط تعقيدات الواقع وفقدانه لتصور ملموس للمستقبل. ينتقد أيضاً غياب اشتغال نظري جاد على مفهوم الجماعة السياسية المعنية في بعض أعمال برهان غليون، ولا ينسى أن يُذكِّرنا بأن الكثير من النخب الديمقراطية والسورية تفتقر إلى ممارسات ديمقراطية بل وتطبعها ميول استبدادية، وبأن أزمة الوطنية الديمقراطية ترتبط بالأزمة العالمية التي تعيشها الديمقراطية.
يبدو ياسين الأكثر جدية في التفكير بهذا النموذج والرغبة في ترميم صرحه، وبخاصة في محاولته للتفكير بـ«نظرية في الديمقراطية»، ولكنه ينتهي إلى صعوبة إنقاذ هذا النموذج الذي لا يلإعلن نهايته بتعجّل أو ببهجة، «فهناك ما هو مأساويٌ بعمقٍ في هذه التحولات الفكرية السياسية التي يلعب النظام، المحلي والدولي، فيها دور القَدَرُ الساحق»، بل وتوحي عودته إلى تناول «أزمة الديمقراطيين السوريين» في وقت قريب إلى أنه لم ييأس، رغم كل شيء، من احتمالات إمكانية تجاوزها.
مؤخراً، عقبَ قيام برهان غليون بنشر كتابه سؤال المصير، قَدَّمَ ياسين الحاج صالح مراجعات نقدية صارمة لعرّاب الوطنية الديمقراطية، ولكتابه الذي يتجاهل العقد الماضي وأسئلته، وبخاصة سؤال الإسلام السياسي، والذي لا يبرر سببَ اختياره العرب بوصفهم «الذات الضمنية في قصة صراع المصير التي يرويها الكتاب». الجدير بالذكر بأن مراجعة راتب شعبو تبدو أقرب للاتفاق مع ذلك، فهي ترى أيضاً بأن غليون «متعبٌ بعروبته» وداعيةٌ لديمقراطية سحرية يمكن اختزالها في «إجراءات وقرارات تتخذها نخبة حين تتمكن من سلطة الدولة».
تدعونا اللحظة الحالية، بسحرها، إلى نسيان كل هذا الشغل النقدي، وإلى العودة إلى كتب غليون، بل وانتظار مقابلاته وتصريحاته، وهو ما نحتاج إلى رفض غوايته. حساسية اللحظة وتاريخيتها تدعونا، على العكس، إلى متابعة هذه المراجعات النقدية والمضي بها خطوات أبعد بكثير. يمكننا، على سبيل المثال، استئناف التفكير الجاد والعياني بالنظرية الديمقراطية وأسئلتها، عبر نقد غياب التفكير الجاد بمقولة «النخبة»، التي تشكل واحدةً من ركائز هذا الخطاب وواحدةً من أكثر المفردات تواتراً في مجمل أعمال غليون. يمكننا أيضاً نقدُ الروح الليبرالية التي تسكن الخطاب الوطني الديمقراطي رغم اشتغاله في أزمنة ما قبل ليبرالية، حقبة سوريا الأسد ولكن أيضاً لحظة استلام الهيئة لزمام السلطة في سوريا.
اليوم، تقودنا هذه الرؤية إلى الرهان على «النخب الديمقراطية» من أجل المساهمة في إعادة بناء الدولة واستئناف نهضتنا، وهو ما يبدو مقاربةً شديدة الاختزال والتفاؤل، فلا يوجد الكثير مما يقول بأن السلطات الانتقالية ستمضي بسوريا نحو لحظة انتقالية جديرة باسمها، ولا يوجد الكثير أيضاً مما يقول بإن عملية بناء الدولة وإحياء الأمة ستضمنُ تَحوُّلَ النخب الديمقراطية إلى قوة سياسية وازنة في سوريا. قد يحدث ذلك بعد عقود، وقد يتحلل الإسلام السياسي إلى تيارات متصارعة منها ما يحمل رؤى تعددية، ولكن هذه الرؤية التفاؤلية للتاريخ لا تقول أي شيء عن السياسات التي يمكن للنخب الديمقراطية أن تبلورها «الآن هنا». هل نكتفي بكتابة مقالات الرأي أملاً بالتأثير في «رأي عام» لا وزن حقيقي له؟ هل يجب التحول إلى مثقفي بلاط وخبراء في حضرة الإسلاميين، على أمل أن يُساعدنا تحصيلنا العلمي ومهاراتنا الخطابية على إقناع الإسلاميين المستحوذين على السلطة بضرورة الديمقراطية؟
من جهة أخرى، وبعد وصول الإسلاميين إلى السلطة، ألن تتحول «خطوط إنتاج» النخب، من جامعات ووسائل إعلام، إلى إنتاج نُسَخ مؤسلمة من النخب السياسية والثقافية والفكرية، لينتفي أي دور عضوي ممكن لنخب ديمقراطية طامحة إلى دولة قانون ومواطنة، تكون فيها السيادة للشعب دون غيره؟ الرعاية القطرية والتركية للسلطات الناشئة في سوريا ذات خبرة كبيرة في تعديل خطوط الإنتاج، ويكفي تَذكُّرُ قُدرة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام الكبرى على تصنيع نخب وإتلاف أخرى في مصانع الرثاثة الكبرى التي تُكوِّنُها.
كتاب عطب الذات لبرهان غليون مدخلٌ مناسبٌ لفهم حدود هذه «النخب» وعجزها عن الفاعلية، فهذا الكتاب الذي يبدو وكأنه محاولة مسؤولة لنقد الذات السياسية السورية عبر استعراض إفلاس النخب السياسية السورية قبالة الكثير من استحقاقات سنوات الثورة السورية الأولى، يكاد يخلو من أي نقد لذات الكاتب، كواحد من أبناء هذا المجتمع السياسي السوري وفاعليه المفتاحيين. بالتأكيد، لا ينقص برهان غليون النباهة أو النزاهة كي يقع في هذا المطب، وأغلب الظن أنه يعتقد أنه قام بانتقاد كل ما يمكن انتقاده، في ذاته وفي المجتمع السياسي الذي ينتمي إليه، بشفافية وإخلاص، وهو ما يُحوِّلُ عدم قدرة كتاب غليون على الإجابة على السؤال فيما لو كان كاتبه مفلساً كزملائه أم لا إلى معضلة مثيرة للتفكير.
الديمقراطي الذي يقرأ كتاب عطب الذات، دون تفكير نقدي في مقولات «النخب» و«السياسة»، وهو يعتقد أن مهمة أبناء النخبة الديمقراطية هي التوليف بين قلوب النخب السياسة من أجل خوض الصراع على السلطة والدولة، لن يجد ما قد ينتقد برهان غليون عليه، ولكن الديمقراطي الواعي بحدود النخب الديمقراطية وتواضع حجمها وعجزها عن فرض إيقاع اللعبة السياسية، والذي يعتقد أن مهمة التيار الوطني الديمقراطي هي التحول إلى أقلية فاعلة وقوة سياسية قادرة على خوض صراعات السياسة، والعمل بنَفَس طويل على إطلاق بعض الديناميات وخوض بعض الصراعات الوطنية، سيتمكن بكل بساطة من انتقاد غياب أي تفكير جاد في السُبُل التي تُمكِّنُ هذه النخب من الفاعلية، أو بما يدعوه ياسين الحاج صالح بغياب النظرية الديمقراطية. النخبة الديمقراطية في تعقيدات الواقع تبدو أقرب إلى برهان غليون في تجربته السياسية الوجيزة، التي بدأها كي يثبت قدرة الرؤية الوطنية الديمقراطية على الانخراط بالواقع وتحويل النظرية إلى ممارسة، ولكنه سرعان ما انسحبَ، مشتكياً من إفلاس النخب الأخرى، وكأن الواقع لا يرتقي لملاقاة النظرية، ما يثبت عجزه عن العمل في هكذا واقع، وما يجعله مُفلِساً آخر في جوقة المفلسين.
من جهة أخرى، تتصف هذه الغليونية بمقاربة شديدة الليبرالية للسياسة، بوصفها فعالية قائمة على الحوار والإقناع والائتلاف، رغم أنها تجري في عالم غير ليبرالي، لا يمكن مقاربته دون الاستناد على مقولات القوة والصراع، وهو ما يَعِد به مستقبل سوريا يحكمها إسلامٌ سياسي ذو ماضٍ سلفي مقاتل، بل وتعدُ به اللحظةُ الراهنة التي تبدو شديدة البعد عن قالب «الانتقال الديمقراطي».
بالإضافة إلى ذلك، يعقوبية الرؤية التي تمتلكها هذه الوطنية الديمقراطية، والتي لا تستطيع أن تتخيل العمل خارج حُجرة قيادة السياسة المسماة الدولة ومشاريع الدولة الأمة، يبدو سبباً آخر من أسباب قلة خصوبتها العملية. مآلات الثورة الفرنسية نفسها، ومآزق الجمهوريات الفرنسية والديمقراطية الفرنسية، يجب أن تدفعنا إلى مراجعة المَرجعية الفرنسية التي تستند عليها هذه الرؤية السياسية، وإلى التفكير في سياسات تحررية أخرى، قادرة على تفكير ملموس وعياني في سؤال الديمقراطية، وعلى الخروج من اتكاليّتنا على مقولات الدولة والنخبة.
بالإضافة إلى ضرورة الاشتغال على «نظرية ديمقراطية»، وما يعنيه ذلك من اشتغال نقدي على مقولات من عالم السياسة والسوسيولوجيا والاقتصاد والتاريخ، يجب على الأزمة العالمية التي تمر بها الديمقراطية أن تدفعنا إلى الاهتمام بالعُمق الفلسفي لهذه المقولة، للخروج من المقاربة السياسوية، والتأسيس لها كقيمة ومقولة كبرى، قادرة على التصالح مع الحلم واليوتيوبيا، فالديمقراطية اليوم، والتي تقدم نفسها بوصفها «أسوأ أشكال الحكم، باستثناء كل الأشكال الأخرى التي تمت تجربتها» لم تَعُد تغري، بصيغتها الإجرائية هذه، الكثير من المجتمعات الإنسانية، ودخلت منذ سنين طويلة في أزمة كبرى عنوانها وصول دونالد ترامب وأمثاله إلى سدة السلطة في الولايات المتحدة.
الاستعانةُ بفلسفة المُحايَثة السبينوزية وامتداداتها الأناركية والليبرالية والنيتشوية والبراغماتية والماركسية الليبرتارية، وقدرةُ هذه الفلسفات على الالتقاء لتقديم أنطولوجيا تحررية في عالم منزوع السحر، يمكن أن تقودنا إلى بناء رؤية شعرية للوجود، تسمح لنا بعيشٍ طيب رغم مفارقته السحر. الديمقراطية، بصيغها الإغريقية والغربية، وقدرتها على إعادة السياسة إلى المدينة، وضرورة السياسة كواحدة من شروط العيش الطيب، وضرورة براغماتية السياسة، لاسلطويتها واشتغالها وفق مقولات الأخوة والحياة اليومية، تشكل احتمالات مقولات كبرى، سمحت لنا تجربتُنا السورية بتلمُّس بعض أثرها، ويمكن في اللحظة الراهنة اختبار إمكانية توليفها في مقاربة شعرية للسياسة والوجود.
سنوات الجلجلة: كي لا ننسى؟
من جهة أخرى، وبعيداً عن الأحلام الفلسفية، قد تُنعش القراءة السحرية للحظة الثامن من كانون الأول الرغبةَ بالنسيان، نسيان سنوات الجلجلة السورية التي لا تُنسى، والتي تَذوَّقَ فيها السوري كل أبعاد العيش في عالم منزوع السحر، وهو ما تسبَّبَ في تَحوُّلِ الاكتئاب، السياسي في عمقه، إلى ظاهرة مجتمعية كبرى. الذاكرة الوجدانية لهذه السنوات، ومحاولات السوريين لتجاوزها، والتجارب الروحية التي انطوت عليها، والخلاصات التي انتهى إليها بعضنا. قد تشكل بعضاً من أعز ما نملك وتجربةً قادرةً على تخصيب إجاباتنا على سؤال سوريا التي نحلم بها.
من جهة أخرى، قد تدفعنا الرغبة بنسيان هذه السنوات إلى نسيان مُكتسباتها أيضاً، والتي تشكل بعض أهم ما عرفته سوريا في تاريخها الحديث، فالمليون ونصف مليون سوري المقيمون في أوروبا، والذين عاشوا تجارب مختلفة جذرياً عن التجارب التي اعتادها السوريون فيما سبق، والذين يتشابهون في الكثير من محدّداتهم السوسيولوجية وفي ظروف معيشتهم، يمكن أن يتحولوا بتقاطعاتهم الاجتماعية الوازنة إلى «كتلة تاريخية» قادرة على تخصيب سوريا ودعم تياراتها التحررية، وعلى ربطها بالعصر والعالم وفق منظور نقدي، تغذّيه تجربة السوريين اليومية في عوالمهم الغربية.
الرغبة بالنسيان قد تدفعنا أيضاً إلى نسيان الحصيلة الإنسانية الهائلة التي دفعتها سوريا في سنوات الجلجلة، باتجاه التصالح مع سياسات ليبرالية اقتصادياً قوامها التسامح مع رغبة شرائح معينة في الرفاه الاستهلاكي والانفتاح، في الوقت الذي تحتاج فيه سوريا إلى الدفع نحو سياسات تنموية لا يمكن تمويلها دون توجهات «يسارية»، تسمح بجبر ضرر عوائل الشهداء والمُغيَّبين، ومساعدة مئات آلاف النازحين على العودة الكريمة والمعاقين على عيش حياة كريمة، أو الاعتناء بالأطفال الذين يحتاج 7.5 مليون منهم إلى المساعدة، وفق اليونيسيف، والذين لا يذهب نصفهم إلى المدرسة ويعاني ثلثهم من صدمات نفسية و650 ألف طفل منهم من سوء التغذية المزمن. لا بد أيضاً من التفكير بالأجيال التي نشأت في أيام الحرب ومساعدتهم على تحسين شروط حياتهم، ومساعدة 90 بالمئة من المجتمع السوري القابع تحت خط الفقر على تأمين خبز يومهم.
من أجل العودة إلى حقائق التاريخ والجغرافيا؟
بالإضافة إلى ذلك، تقودنا القراءة السحرية لهذه اللحظة إلى رؤية إرادوية ورغائبية فيما يتعلق بطبيعة السلطة الجديدة في سوريا واحتمالاتها البونابارتية، وإلى التمركُز الشديد حول سوريا، متناسين أن لحظة انهيار النظام هي أيضاً محصلة لصراعات إقليمية جيوسياسية كبرى، أنهكت الراعي الإيراني وقضت على مشروعه في المنطقة. بكلمات أخرى، ما يدعونا إلى نزع سحر اللحظة أيضاً هو تراكُبُ الديناميات التي أدت إلى هذه اللحظة والعمقُ الجيوسياسي الذي مَيَّزها، فما حصل في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) لا يكتفي بالارتباط بمسار الصراع السوري الدائر منذ سنوات طويلة، بل ويبدو أكثر ارتباطاً بالسيرورة التي افتتحتها عملية 7 أكتوبر، وبتآكل سطوة حزب الله وسائر الميليشيات الإيرانية في المنطقة، والذي جعل المنظومة العسكرية السورية، المهترئة منذ عقود، عارية تماماً أمام عملية ردع العدوان، التي قادتها كتائب منظمة ومنضبطة، تمتلك من وجوه الشبه مع الجيوش الحديثة أكثر بكثير مما يمتلكه «جيش أبو شحاطة»، والتي قد يجبرنا بنيانها هذا على الانتقال من دلف الجيش العُصبوي إلى مزراب الجيش العقائدي.
من جهة أخرى، سقوطُ النظام واستفرادُ الإسلاميين بالسلطة والمجتمع هي مرحلة جديدة على السوريين بكل تأكيد، ولكن على العالم أيضاً، فلم يَعُد يمكن لسيسي سوري أن يُولَد، ولا بدّ للمجتمع السوري والعالم أن يتفاهموا مع الإسلاميين، وهو ما يبدو مفتوحاً على احتمالات كثيرة تجعل الاكتفاء بمتابعتها حرقاً للأعصاب ومحاولةَ تنبؤ شديدة العبثية.
ما يجري قد يشكل لحظة البداية لسيرورة إقليمية كبرى عنوانها وصول الإسلاميين إلى سلطة، يحتكرون فيها عنفاً خفيفاً يسمح لهم بالحكم ويُجبرهم على السياسة، وهو ما قد يعني تحوّلَها إلى المسمار الحقيقي الأول في تابوت النظام الرسمي العربي، الميت منذ عقود والذي لا تتوقف رائحة جثته عن خنق أبناء المنطقة. ارتباط هذا الحدث العملاق وتزامنه مع «الترتيب الجديد» الذي وعدت به اسرائيل بعد إبادة غزة يأتي ليؤكد على جِدّة المرحلة، وعلى استحالة تقديمِ الوطنية الديمقراطية الكلاسيكية إطاراً نظرياً قادراً على تمكيننا من التفكير بأسئلتها.
عشنا خمسة عشر عاماً في عالم منزوعِ السحر، وها نحن نعيش لحظةً قد لا تعرف سوريا بكل تاريخها ما يتجاوزها في الغواية. يمكننا الاستسلام لغواية السحر، ولكن يمكننا أيضاً العمل على الخروج، معاً، من الوصاية والقصور، على حد تعبير كانط، عبر رفض الاستسلام لأوهام السحر والتمسُّك باحتمالات العيش الطيب، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبكل ما تقتضيه من سياسة، لنصبح فناني وجودنا، على حد تعبير نيشته وماركس، ونتمكن من استبدال غواية السحر بصنعة الشعر.
موقع الجمهورية
———————————
هل لدى أحمد الشرع خطابٌ وطنيٌّ للسوريين؟/ عمار ديوب
18 يناير 2025
أصبح السوريون يتساءلون عن موعد توجه قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بخطابٍ “رئاسيٍّ”؟ فهو الرجل الأول في البلاد ولا بد أن يلقي خطاباً جمهورياً. ويتعلق هذا السؤال بإشكالية تبنّي الحكومة المؤقتة سياسات تؤزّم الأوضاع العامة أكثر فأكثر، كتحرير السوق ومن دون خطة اقتصادية للنهوض الاقتصادي، وطرد مئات ألاف العمال، وتبنّي رؤية محافظة للتعليم، والتعطيل المستمر للقضاء، ووجود فصائل خارج جيش البلاد، والبدء بتشكيل هذا الجيش بشكلٍ أربك السوريين وقيادات الفصائل غير المنضوية في هيئة تحرير الشام، وقضايا كثيرة أخرى.
باعتباره الرجل الأول، في الهيئة وفي سورية، فهو يحاول أن يعرف ماذا يريد منه الخارج، بتنوّع هذا الخارج، وكيف سيرتقي بهيئة تحرير الشام من واقعها هيئة عسكرية سلفية إلى أن تصبح السلطة الوطنية في دمشق، ومغادرة مواقعها السلفية إلى الموقع الوطني. من دون الموقع الأخير، ستتراجع الثقة كثيراً بالهيئة والإدارة الجديدة، وقد تحدُث الصدامات مع الفصائل، وقد يكون التأخّر بحسم وجود السلاح خارج الجيش متعلقاً بهذه الإشكالية، وبالتالي، يتأخّر الشرع بالخطاب بقصد أن تستقر له الأوضاع، وهذا غير ممكن قبل انجلاء الموقف الأميركي، ولا سيما بعد تسلم دونالد ترامب الرئاسة، ومصير وجود القوات الأميركية شرق سورية، وبعد أن يَحتكر السلاح، وحينذاك يستطيع الكلام.
ليست الهيئة التي كان الشرع يتزعمها على قلبٍ واحد، ففيها تعدّد فصائلي، ورؤوس كثيرة، وبعضها يريد تشكيل دولة إسلامية متشدّدة، ومنها دولة إسلامية معتدلة، ومنها من غادر إدلب وذهب إلى الصحراء للالتحاق بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعدا ذلك، يرى قادة الفصائل كل منهم بنفسه القدرة ليكون قيادياً في الجيش، وهنا تعقيد كبير. يعقد الرجل اجتماعاتٍ كثيرة، معلنة وسرّية، يريد حسم نقاشات وصراعات كثيرة داخلية، ليستطيع تبنّي رؤية وطنية للحكم لاحقاً، فهو حتى اللحظة لم يتكلم عن شكل الحكم مثلاً. خارجياً، عليه كثير من الضغوط العربية والدولية، وجميعها لا تزال تضغط لتطبيق روح قرار مجلس الأمن 2254، وبقصد تشكيل حكومة وطنية، وغير طائفية، وتتمثل فيها كل فئات المجتمع، بينما اضطر هو، وتحت ثقل التعدّد داخل هيئة تحرير الشام، للإتيان بحكومة إدلب إلى دمشق، مع الادّعاء أن حكومة اللون الواحد تساعد على اتخاذ القرارات بشكل أسهل وأسرع، سيما أن البلاد في حالة معقدة، وتتطلب قرارات سريعة فيما يخص الأمن والوضع الاقتصادي وسواهما.
القضيتان أعلاه هامتان، هيئة تحرير الشام والخارج، وهناك مسألة الإعلان عن خريطة للانتقال السياسي، وكيف ستبدأ المرحلة الانتقالية في مارس/ أذار المقبل؟. … والقضية الثالثة، وتتكثف في مطالب داخلية، وتتلاقى مع شروط خارجية بشأن تنفيذ جوهر قرار مجلس الأمن 2254 في تشكيل هيئة انتقالية تعلن عن تشكيل حكومة انتقالية، أو عقد مؤتمر وطني، أو إعلان دستوري مؤقت، وجميعها تستدعي خطّة وخريطة وبجدول زمني محدّد. لا يكفي في هذا ما قاله أحمد الشرع عن أربع سنوات لإقرار الدستور وسواه، وإنما يستدعي تشريع إدارته وحكومته ما ذكر أعلاه.
قد يتأخّر خطاب الشرع إلى بداية شهر مارس/ آذار، وحينها يكون قد استجلى سياسات الخارج تجاهه، وضبطَ الخلافات داخل هيئة تحرير الشام، ومع الفصائل خارجها، وتحدّدت السياسة الأميركية تجاه سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكذلك حُسمت مسألة توحيد البلاد بشكل نهائي، وانضوت الفصائل داخل الجيش المعاد تشكيله. ويخطئ الشرع كثيراً إن كان وإدارته يعملون من أجل فرض سلطة شمولية عبر إعادة تشكيل أجهزة الأمن والجيش، والتراجع عن تحقيق أهداف السوريين في الانتقال الديمقراطي وإرساء أسس الدولة الحديثة.
وهناك مشكلة كبرى تتعلق بالأقليات، العلويين والدروز والأكراد بصفة خاصة، ويمكن ضم المسيحيين والإسماعيليين كذلك. المشكلة مرتبطة بخشيةٍ وخوفٍ من الإدارة الجديدة، التي صفتها الأبرز أنّها إسلامية الهوى والسياسات. حُلّت جزئياً هذه التخوفات عندما بسطت الهيئة سيطرتها على حلب وحماة وحمص، ولكن بمجرّد الاستيلاء على السلطة برزت تلك الإسلامية في توجّهات الحكومة، وعادت مجموعات من الفصائل لتمارس أسلمتها، ولا سيّما تجاه العلويين في حمص واللاذقية بالتحديد.
برز كلامٌ عن حماية دولية من بعض الشخصيات من الطائفة العلوية، وهناك وجود أميركي حامٍ للأكراد، وقد نرى شخصياتٍ أخرى، ومن طوائف أخرى، تطالب بالشيء ذاته، ومن دون أن ننسى التقدّم الصهيوني إلى مشارف دمشق، وتوجهات دولة الاحتلال في تفكيك المجتمع السوري إلى طوائف وإثنيات، وهي تعلن بوضوح رغبتها في دعم الدروز والأكراد والعلويين وتقسيم سورية. … حسناً، لتشكيل رؤية أكثر واقعية، لقد جرت المطالبة بالحماية الدولية في العام 2011، بهدف إيقاف الهجوم الوحشي للنظام على المدن وتدميرها وتهجير سكانها وقتل الآلاف، وبغض النظر عن محدودية الانتهاكات للعلويين بصفة خاصة، والحرب المتقطّعة بين فصائل الجيش الوطني و”قسد”، فإن قضية المطالبة هذه تفرض على الإدارة كثيراً من السياسات الهادئة وغير الطائفية لتوحيد البلاد وعزل الأصوات غير الوطنية. يتطلب هذا الأمر الركون إلى مشروع وطني، ورؤية وطنية في كل سياسات الإدارة والحكومة المؤقتة، وحتى في كيفية ضبط الأمن في كامل البلاد، ولا سيما في المدن التي شهدت مجازر وحشية بدلالات طائفية علوية من النظام في السنوات الأولى للثورة، كحمص واللاذقية وبانياس، وأورثت ثارات وانتقامات بين الأحياء المتجاورة والمختلفة مذهبياً.
إذاً، هناك ضرورة للضبط الأمني السريع، ومنع الانفلاتات كي لا تتشكّل مسألة أقليات. وفي هذا، يشكل الخطاب الوطني والممارسات الوطنية الدولتية مع كل السوريين، الجدار الصلب لكل دعوة غير وطنية، أو طلب الحماية الدولية أو الاحتفاظ بالسلاح في هذه المدينة أو تلك. وهناك المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه تتطلّب الإسراع بتأمين الخدمات الأساسية، وإيجاد حلول إيجابية للموظفين المدنيين والعسكريين، ومنع تشكل كتلة اجتماعية متأزمة وقابلة للانفجار.
ينتظر السوريون خطاباً جامعاً، يضع أسس الدولة الحديثة، ويعبر عن أهداف الثورة في 2011، فهل يمتلكه أحمد الشرع؟
العربي الجديد
————————
ما لا يُحكى عن التحول السوري الكبير/ عمر قدور
السبت 2025/01/18
عاد الهاجس الأمني بقوة في الأيام الماضية، خصوصاً في حمص والساحل، حيث تمكنت قوات الأمن من السيطرة بسهولة على محاولات لإثارة الفوضى أو المشاكل الطائفية من قبَل بعض شبيحة العهد البائد. ونال الموضوع الأمني وتعقيداته اهتماماً يوازي الاهتمام بالظواهر الدعوية التي تزايدت في الوقت نفسه، وأثارت جدالات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الغضون، تابعت السلطة نشاطها الخارجي الذي يهدف إلى طمأنة الدول الفاعلة إقليمياً، وإلى الحصول على دعمها المالي، ودعمها السياسي لدى دوائر القرار الدولية. واستمر السيد أحمد الشرع في استقبال وفود خارجية، واستقبال رجال أعمال سوريين ينشطون في الخارج، وقد عبّر البعض منهم عن تفاؤله بالمستقبل، ما يعني أنه حصل على إشارات مطمئنة تخص البيئة الاقتصادية في البلاد. بدورها صرّحت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، أن المصرف لديه ما يكفي لتغطية رواتب القطاع العام حتى بعد زيادتها بنسبة 400%، وهذا يدعو إلى التفاؤل رغم تعثّر دفع الرواتب “بلا زيادة” هنا أو هناك لأسباب يُفهم أنها إدارية.
يُستنتج من مجمل الأخبار أن سوريا تودّع مرحلة سُمّيت بـ”اقتصاد السوق الاجتماعي” إلى عصر اقتصاد السوق الحر، وهذه النقلة تبدو من البديهيات التي لا تخضع لنقاش عام، أسوة بالاهتمام الواسع بالموضوع الأمني والدعوي، باستثناء إشارات قليلة متفرقة عن الكلفة الاجتماعية للتحول الاقتصادي. وأهم ما يجعل النقلة في مرتبة البديهية هي النظرة السلبية لدى نسبة كبيرة من السوريين إلى اقتصاد القطاع العام الذي سيؤول إلى الزوال، وهكذا يُعرَّف اقتصاد السوق الحر ضمناً بأنه النقيض لمساوئ سلفه، من دون أن يُحكى عن الجديد ما يليق بتحوّل ضخم في بنية الدولة السورية ككل.
نتحدث هنا تحديداً عمّا لا يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي يستحق بحثاً منفصلاً. وأهم ما لا يُحكى ويناقش هي العلاقة بين البيئة الاقتصادية وشكل الدولة السياسي، حيث يأخذ النقاش “القليل” في شكل الدولة منحى طائفياً بمعظمه، وبحيث تبدو مطالبات البعض بالديموقراطية متسرعة في حدها الأدنى، أو غير مناسبة بالنسبة للذين يتحدثون بمنطق الغلبة، وبأحقية الطرف الغالب بتقرير مصير الحكم والدولة. وفق بعض الجدالات، تظهر المطالب الديموقراطية كأنها فئوية، أقلوية أولاً لصدورها عن أبناء “الأقليات”، وأقلوية ثانياً لصدورها عن “نخب” ثقافية لا يندر إطلاقاً أن تُهجى بزعم ابتعادها أو انفصالها عن الواقع.
هذه المهاترات تضيّع، في أحسن ظن، فرصة الانتباه إلى التحدي الواقعي والحقيقي فيما يخص التحول المنتظَر. فمن البديهيات المتصلة باستقطاب رأس المال تأمين بيئة آمنة له، وهذه البيئة تقوم على الاستقرار السياسي، وأيضاً على وضوح الرؤية والتوجّه الاقتصاديين المدعومين (بالضرورة) ببيئة قانونية تحمي الرأسمال. ويشتد إلحاح هذه المطالب إثر حدوث اختلال شديد في استقرار الدولة، ثم يشتد أكثر لأن الحالة السورية كانت طاردة استثمارياً منذ بدايات حكم البعث، وإعادة الثقة لن تأتي دفعة واحدة، أو بقرارات غير جذرية.
اليوم ثمة بلد مدمّر منهك، يحتاج مئات مليارات الدولارات من أجل التعافي، وقسم معتبر منها سيأتي عبر مانحين دوليين. إلا أن التعويل على المانحين يعني الاعتماد على المال السياسي، لأن جزءاً على الأقل من المنح سيكون مشروطاً بمواقف سياسية. كذلك سيكون حال الاستثمارات التي تأتي مدفوعة فقط بالاعتبارات السياسية، لأنها ستنسحب إذا حصل الافتراق السياسي لاحقاً. لدينا تجربة على هذا الصعيد مع المساعدات الخليجية التي قلّما انقطعت أيام الأسدَيْن، ولم تكن لها فائدة على مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد.
في الواقع ثمة خشية من أن تعتمد سوريا في السنوات المقبلة على المساعدات الخارجية، وعلى القليل المتوفر من ريع النفط والغاز، فيكون النشاط الاقتصادي الغالب مزيجاً مما هو ريعي و”إن جي أوزي”. وجه الخشية هو أن يُضحّى بالاقتصاد مرة جديدة على مذبح السياسة، وأن تكون الأخيرة هي الطاغية والمهيمنة، والمعيقة تالياً للاستثمارات المنشودة. الحديث هنا، بلا لبس، عن الترابط العضوي بين الحرية والديموقراطية في السياسة وبين اقتصاد السوق الحر.
لا توجد ليبرالية اقتصادية من دون ليبرالية سياسية. النموذج الصيني هو ما كان يُشار إليه بعنوان “اقتصاد السوق الاجتماعي”، ويتم التخلّي عنه حالياً، بصرف النظر عما إذا كانت العلّة فيه أو في تنفيذه من قبل العهد البائد. أما تجربة الخليج في الفصل بين الليبرالية الاقتصادية وشقّها السياسي فهي مسنودة أساساً بريع نفطي ضخم، وبأنظمة وراثية مقبولة اجتماعية بما يكفي للاستقرار السياسي. الأمر بالطبع مختلف مع نظام اعتُدي عليه بتحويله إلى جمهورية وراثية، وبلد لا يملك فائضاً ريعياً، بل لا يستطيع الإقلاع بقواه الذاتية.
الحل المستدام المطروح هو باقتصاد السوق الحر، وهذا يقتضي الوضوح فيما يخص التحول الديموقراطي، لئلا ينتهي شعار اقتصاد السوق إلى مجموعة ضيقة من المستثمرين المعتمدين على علاقاتهم الشخصية بالسلطة، لا على الثقة المعممة بالمناخ الاستثماري في البلد. وبما أن هذا هو الحل المطروح فمن المهم النظر إليه، وإلى عوامل إنجاحه.
في النظر إليه، يمكن القول من الجانب الإيجابي إن نهضة اقتصادية هي وحدها التي ستتكفل مع الزمن بحل العديد من المسائل العامة. منها، على سبيل المثال، المسألة الوطنية التي ستأخذ طريقها إلى الحل مع تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وفي الشق الداخلي، من المأمول للنشاط الاقتصادي أن يصطنع روابط بين السوريين أنفسهم، تقوم على لغة المصالح وتتجاوز الانقسامات الدموية السابقة، خصوصاً إذا كان الاستثمار الاقتصادي قريباً من التوازن على المستوى الكلي، وتستطيع الدولة لأجل هذا الهدف منح تسهيلات ضريبية تتعلق بمكان المشروع ونوعيته.
أما عن إنجاح هذا التطلع، فيحتاج أن يتم الحوار حوله منذ الآن، وأن تكون السلطة الحالية جزءاً من الحوار العام، فتقدّم رؤيتها المتكاملة اقتصادياً وسياسياً إلى العموم. إن مجيء رجال أعمال إلى دمشق، ثم تصريحاتهم المتفائلة، شأن مختلف عن عودتهم مع رؤوس أموالهم، والحديث أولاً عن مستثمرين سوريين يمكن لهم المساهمة بعشرات مليارات الدولارات. بالحوار، يمكن وضع الكثير من القضايا في مكان مختلف عن الجدالات السقيمة، فمثلاً لا يمكن تنشيط القطاع السياحي مع أيديولوجيا حاكمة متزمتة، ولا يمكن أيضاً تنشيطه (داخلياً وخارجياً) من دون صناعة ترفيه نشطة.
واحد من أوجه الصراع السياسي في المستقبل أن يختلف السوريون على الدور الاجتماعي للدولة وعلى توزيع “الثروة”؛ هذا يأتي بعد إنتاج الأخيرة، وعلى نحو مغاير لما كان عليه خلال عقود عندما كانت السلطة مدخلاً لاحتكار السياسة وريع الثروات العامة معاً. وبسبب الترابط بين السياسي والاقتصادي يمكن القول أن الديموقراطية في الحالة السورية تساوي تأمين لقمة الخبز، الآن وللأجيال المقبلة، وهي ليست ترفاً نخبوياً أو أقلوياً. وإذا صدقت النوايا فمن المستحسن الانتباه إلى البعد الاقتصادي للديموقراطية، أما معاندتها بمزاعم عديدة، في رأسها الخصوصية الثقافية، فلن تؤدي إلا إلى إعاقة سوريا الجديدة منذ ولادتها.
المدن
—————————————-
تحديات النموذج السوري في التغيير/ عمر كوش
18/1/2025
شكّل سقوط نظام الأسد، وانهيار جيشه السريع أمام زحف فصائل المعارضة السورية التي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تحولًا كبيرًا في تاريخ سوريا على الصعيدين؛ الداخلي والخارجي، وأشاع موجات عالية من الأفراح والاحتفالات لدى السوريين، الذين قدموا تضحيات جسامًا من أجل الخلاص من نظام الأسد الاستبدادي.
النموذج السوري
يمكن القول إن تمكن فصائل المعارضة السورية، بقيادة “هيئة تحرير الشام”، من الوصول إلى مفاصل الحكم في سوريا، شكل نموذجًا جديدًا في التغيير، حمل معه عودة الإسلاميين إلى واجهة المشهد السياسي، عبر اتخاذ العمل المسلح حاملًا لمشروعهم الرافع لراية الثورة السورية، وذلك بالافتراق عن نموذج العمل السياسي الذي سلكته بعض التنظيمات الإسلامية المعتدلة في بلدان، مثل المغرب، ومصر، وتونس، وعن المسار العنفي الذي اتبعته تنظيمات إسلامية رفعت راية الجهادية العالمية.
فضلًا عن أن النموذج السوري قدم خطابًا متصالحًا مع دول الجوار ومع دول الغرب والعالم، الأمر الذي يفسر تقاطر وفود الدول الغربية والعربية إلى العاصمة دمشق، متجاوزة التصنيفات التي وضعت هيئة تحرير الشام في خانة المنظمات الإرهابية.
التحديات
يواجه النموذج السوري في التغيير تحديات عديدة، ستختبر مدى قدرته على إعادة بناء الدولة السورية وفق مندرجات وأسس جديدة، تقطع مع تلك النماذج التي قدمتها حركات الإسلام السياسي بمختلف تنوعاتها ومشاربها، وانتهت معظمها إلى الفشل الذريع في تحقيق الأمن والاستقرار، حيث لم تتمكن من بناء نموذج دولة وطنية مستدامة، بل عجزت عن تشكيل حاضنة شعبية واسعة وقوية حولها.
وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه الإدارة الجديدة في سوريا ليس فقط في مطابقة الأفعال مع الأقوال، كما يطالب مسؤولون غربيون، بل في إحداث قطيعة سياسية وإبستمولوجية في العلاقة بين السياسة والإسلام.
تحديات الداخل السوري
تبرز على مستوى الداخل تحديات واستحقاقات عديدة، حيث يتطلع السوريون إلى أن تقدم الإدارة الجديدة ما يمكنه تحقيق وعود الثورة السورية، التي اندلعت في منتصف مارس/ آذار 2011، المتمثلة في بناء سوريا جديدة وفق مبادئ التعددية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.
لكن هواجسهم لم تنقطع، بسبب ماضي الفصائل المتشددة، التي تولت إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف شرائح من السوريين من انفرادها بالحكم والعودة بهم إلى الوراء، لكن ذلك لم يؤثر على تطلعهم في ألا تنسى الإدارة الجديدة حجم تضحياتهم ومعاناتهم.
وأن تعي حجم التحديات الداخلية التي تواجهها، وتتصرف بحكمة وتعقّل في المرحلة الانتقالية، التي تتطلب القيام بخطوات مدروسة من أجل الوصول إلى غدٍ أفضل لجميع السوريين، وذلك عبر إشراك مختلف أطيافهم في صنع مستقبلهم، واتخاذ إجراءات باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مندرجات الحكم الرشيد، وبما يقطع مع نهج الاستبعاد والإقصاء والتهميش الذي كان سائدًا خلال عهد النظام الاستبدادي.
إذًا، يواجه النموذج السوري تحديًا يتمثل في اختبار قدرة الإدارة الجديدة على إدارة التنوع والتعددية التي يمتاز بهما المجتمع السوري، سواء على المستوى الديني، أم الإثني، حيث يتطلب هذا الواقع المجتمعي إدارة حكيمة، والابتعاد عن ممارسات الإقصاء أو التهميش، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع، مع احترام التعددية كقيمة أساسية في بناء الدولة.
يعوّل السوريون على الإشارات الإيجابية التي صدرت من الإدارة الجديدة، والتي جسدتها في التعامل المنفتح مع كافة أطياف المجتمع وإقرارها بالحق في ممارسة كافة الشعائر والطقوس الدينية، وعدم التدخل في الحريات الشخصية، سواء المظهر أم اللباس.
والأهم أنها لم تلجأ إلى ممارسات الثأر والانتقام، بل أوجدت مراكز تسوية لكافة أفراد جيش النظام وأجهزة أمنه، ولجأت إلى تنظيم حملة أمنية ضد فلول النظام السابق، بالتزامن مع توجهها إلى الاستعانة بالوجهاء والأعيان في المناطق التي تحصنوا فيها.
وتعاملت الإدارة الجديدة بحزم مع محاولة الفلول الإخلالَ بالأمن، والاعتداء على عناصر أمن الهيئة، وترافق حزمها بشيء من الحكمة، حيث لم تعتبر الأحياء والمناطق، التي تخفّى فيها المتهمون بارتكاب جرائم، بيئة معادية، بل توجهت إلى ممثلي المجتمعات الأهلية في تلك المناطق والأحياء، الذين أبدوا تجاوبهم معها، ورفضوا كل محاولات إثارة النعرات الطائفية.
كما شكلت الإدارة الجديدة لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر وطني جامع لكل مكونات المجتمع السوري، الذي ستعلن فيه حلّ هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى التي ستنخرط في مؤسسة الجيش، وسيتم فيه تشكيل حكومة كفاءات، وحل البرلمان، وإيقاف العمل بدستور 2012، وستشكَّل لجان قانونية وحقوقية من أجل كتابة دستور جديد، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
تعي الإدارة الجديدة حجم التحديات على مستوى الداخل، وأهمها التحدي الأمني، حيث سعت منذ الأيام الأولى إلى سحب السلاح غير الشرعي، وحصره بيد الدولة عبر مؤسسة الجيش الذي بدأت بإعادة تشكيله.
إضافة إلى تحدي تأمين الحاجيات الأساسية للسوريين، الذين يعانون من التركة الثقيلة للنظام السابق، وأكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، وبحاجة ماسَّة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فضلًا عن التحدي الاقتصادي والتنموي، حيث تحتاج سوريا إلى أكثر من 500 مليار دولار من أجل إعادة إعمار ما دمره نظام الأسد، ما يعني أنها بحاجة إلى تدفق الاستثمارات العربية والدولية من أجل ذلك.
هذا يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم يعد لها مبرر بالنظر إلى أنها فرضت على نظام الأسد البائد لسلوكه الدموي حيال السوريين.
ويبدو أن الإدارة الأميركية بادرت إلى التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يسمح برفع سوية الخدمات الضرورية الأساسية كالطاقة والكهرباء والمياه، وذلك دعمًا للخطوات السياسية التي تتخذها الإدارة الجديدة في المرحلة الانتقالية.
التحديات الخارجية
لا تقتصر التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة على الداخل السوري، بل على مستوى الخارج، الذي يحفل بتحديات كثيرة، حيث رحبت دول عديدة بها، وأبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، فيما لم تخفِ دول أخرى في الإقليم معارضتها ورفضها هذا النموذج.
فقد سارعت دول عديدة إلى إرسال وفودها إلى العاصمة دمشق، وتجاوزت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، بالاستناد إلى الإشارات الإيجابية التي قامت بها الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام.
بالمقابل، أدركت الإدارة الجديدة أهمية علاقاتها الدولية والعربية، فأرسلت رسائل طمأنة عديدة لدول الجوار والعالم؛ مفادها أن سوريا لن تكون عامل عدم استقرار، بل ستتبع سياسة صفر مشاكل معها، وأنها ليست في وارد تصدير الثورة، التي انتهت بسقوط النظام.
كما أدركت أهمية عودة سوريا إلى المنظومة العربية، فأرسلت وفدًا رفيع المستوى إلى كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.
بدورها، أدركت هذه الدول العربية أهمية سوريا، وضرورة دعمها للتعافي وإعادة إعمار ما خربه نظام الأسد، وعدم تركها مثلما فعلت مع العراق بعد الغزو الأميركي.
على المستوى الدولي، نظرت الولايات المتحدة بإيجابية للتغيير الحاصل في سوريا، واعتبرت الإدارة الجديدة سلطة أمر واقع، وأرسلت وفدًا إلى دمشق، وكذلك فعلت كل من فرنسا، وألمانيا، وأبدت دول الغرب استعدادًا للتعاون المشروط مع الإدارة الجديدة، حيث صرح مسؤولون غربيون بأنهم يراقبون الأفعال التي ستقوم بها، وأرسلت الولايات المتحدة رسالة حسن نيّة تمثلت برفع جزئي ومؤقت للعقوبات الاقتصادية على سوريا، في انتظار رفعها العقوبات على الدولة السورية وقطاعاتها الحيوية.
هناك مؤشرات عديدة على رغبة الإدارة الجديدة تأسيس علاقات دولية جديدة، قوامها الاحترام والمصالح المتبادلة، وتأمل في أن يسهم المجتمع الدولي بمساعدتها في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا المدمرة، التي يعاني غالبية سكانها من وطأة الفقر والتهميش وتبعات النزوح واللجوء.
ولعل التحديات التي تواجهها كثيرة، وتتطلب إيجاد آلية لتشكيل هوية سياسية جامعة، وجعل نموذج التغيير ينحو نحو تأسيس دولة تعاقدية مدنية ذات طابع إسلامي منفتح، ولا شك في أن الطريق ليس مفروشًا بالورود أمام الإدارة الجديدة، التي ستواجه العديد من التحديات والاستحقاقات.
—————————-
عن سوريا وأهلها… إرث الخوف وتجديد الأمل/ حنان البدوي
كاتبة وباحثة مصرية
أفكر أن ما يجمعني بسوريا وفلسطين ليس الانخراط في السياسة وقضايا الثورة والتحرر فحسب. بل تجمعنا مشاعر أعمق؛ نتاج كثيف لتجارب إنسانية مشتركة متعددة الأوجه. ربما ما يجمعنا هو إرث أجيال حملت مآسي الشرق، ممزوجة بالموسيقى والضحك والدموع والحنين وقصص الحب وطعم الرمان ورائحة الياسمين.
“سوريا بدها حرية..سورية بدها حرية”
يتردد صدى الهتاف في أذني كأن أيام الثورة الأولى حدثت بالأمس.
أحببت دمشق كما لم أحب مدينة أخرى. دمشق -التي زرتها مرة واحدة قبل زمن الثورة والحرب- بدت لي الأدفأ والأطيب والأحن بين سائر المدن العربية التي خبرتها. في دمشق رأيت ملامح من حميمية القاهرة، ومرح بيروت، وسلاسة عمّان. هناك شيء ساحر في تلك المدينة العريقة بالتأكيد. هناك طيبة بادية على أهلها وحزن مقيم فيهم بلا شك. هناك جمال في ساحة المسجد الأموي يأسر من يمر به، فيحمل أثره في القلب إلى الأبد. هناك أبد إذن مُستقره في القلوب، غير ذلك الأبد الثقيل الذي ظل جاثمًا على نفوس أهل سوريا عشرات السنين.
***
في عام ٢٠١٤ كانت تجربة عملي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر تقارب نهايتها، وكذلك تجربة الثورة، حين سافرت إلى الإسكندرية لإجراء سلسلة مقابلات مع مجموعات من اللاجئين السوريين. كان ذلك في مستهل محاولات آلاف السوريين النجاة عبر قوارب تعِد بالعبور إلى بر الأمان على الجانب الآخر من البحر المتوسط. مهمة العمل تلك التي لم تستغرق سوى أيام ثلاثة، تحولت تورطًا عاطفيًا لم ينتهِ مع نكبة اللاجئين السوريين.
أتذكر جيدًا عبد الغني، تاجر الملابس الميسور الذي فرّ بعائلته من غوطة دمشق إلى القاهرة بعد أن “نزل الصاروخ سوى البيت بالتراب”. كان مسكنه في الإسكندرية خاليًا من أي أثاث، سوى حصيرة نظيفة. خلعت حذائي فورًا دون أن يطلب مني أصحاب البيت، وجلست متربعة على الأرض لأجمع حكاياتهم.
كيف فتح لي هؤلاء الخارجين توًا من مركز لاحتجاز “المهاجرين غير الشرعيين” في مصر مساكنهم المؤقتة وقلوبهم العامرة بكل الود والكرم؟ كيف تحولت سلسلة مقابلات هدفها سرد مأساتهم، إلى مجلس سمر تحدثنا فيه حول التاريخ المشترك والمستقبل المجهول، بينما يصرّون على أن أشاركهم ما تيسّر من طعام؟
أخبرني محمد، الشاب السوري العشريني حينها، حكاية عن خروج الفلسطينيين في نكبة ١٩٤٨: “أثناء خروجهم من ديارهم في فلسطين قال الأب لابنه: هات معانا كيلو سكر، فرد الابن: كفاية نص كيلو…سفرنا لن يطول”.
أربعة عشر عامًا مر. طال السفر، وتكاثرت أوجه الشبه بين نكبة فلسطين ونكبة سوريا.
من بلد النكبة الأولى، التقيت بفؤاد، الفنان التشكيلي الفلسطيني الذي خرج تلك المرة من مخيم اليرموك مصممًا على الوصول إلى بلد أوروبي، حتى يحصل على جواز سفر يمكنه من العودة لفلسطين ورؤية أولاده. كرر فؤاد محاولة الفرار على ظهر القوارب مرة تلو الأخرى، غير عابئ إن كلفه ذلك حياته غرقًا في البحر.
في كل مرة كنت أشاهد أخبارًا عن غرق سوريين تعلقوا بأمل النجاة وقوارب الهجرة في عرض البحر المتوسط، كنت أفكر في فؤاد، وفي عبد الغني، ومحمد وحسن وخالد وعماد ورائد وعائلاتهم، وفي ذلك المسكن المؤقت في الإسكندرية الخالي من أي أثاث سوى حصيرة نظيفة، وفي أحاديثنا وابتساماتهم، متمنيةً لهم النجاة.
***
حين انتقلت للدراسة ثم العمل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حملت معي إرث الثورة والهزيمة ونكبة اللاجئين السوريين. كنتُ أدير برنامجًا جديدًا معنيًا بشؤون اللجوء والهجرة القسرية، وتجدد تواصلي الكثيف مع اللاجئين السوريين بين الولايات المتحدة ولبنان.
في خريف ٢٠١٦، سألت مصطفى، الناشط السوري في مجال “الديمقراطية والعدالة الانتقالية”، والذي بالطبع خرج من سوريا في نهايات ٢٠١١ بلا أفق لعودة قريبة: “بعد كل تلك الخسارات والمنفى والشتات… هل يعتريك الندم؟ هل تتمنى لو أن الثورة لم تحدث؟”. كان ردّه حاسمًا بأن طالبي الحرية لا يمكن أن يندموا، وليس أمامهم خيار سوى الاستمرار في السعي، علّهم يشهدون ثمار سعيهم يومًا ما… بَعُد أو قرب. أبهرني ثباته، بينما كنت أخلق لنفسي فقاعة من اليأس تعين على معايشة الهزائم المتتالية.
في شتاء العام نفسه، زرت عدة مواقع للاجئين سوريين في لبنان. التقيت في البقاع أطباء سوريين يعملون بمنتهى الجدية، ويذللون كل الصعوبات، يؤسسون مراكز طبية وتعليمية ويسعون إلى تطويرها وتحسين الخدمات التي كانت تقدمها للاجئين السوريين والفلسطينيين، كما للمواطنين اللبنانيين. سألت نفسي: كيف يقدر هؤلاء على هذه المثابرة بعد كل تلك الأهوال، بينما أجد أنا راحتي في اليأس؟
كنا نجلس في بار أبو إيلي نستمع لطائفة من الأغاني المصرية والفلسطينية واللبنانية، حين حكيت لغسان عن تورّطي العاطفي مع سوريا، وعن مقابلات الإسكندرية التي أفكر فيها كثيرًا. شاركته رأيي بأننا -معشر الثائرين الحالمين في مصر- نحمل وزرهم: وزر ملايين السوريين الذين ألهمناهم في ربيع ٢٠١١، فخرجوا طلبًا للحرية ينادون بإسقاط الأسد…نحن من “غررنا بهم”، ثم لم نكرم ضيافتهم، ثم صددنا أبوابنا في وجوههم. يدفعون هم من الأثمان ما لا طاقة لنا به، بينما نضجّ نحن بالشكوى.
سألت غسان الآتي من مخيم اليرموك عمّا إذا كان ربما يعرف فؤاد -الذي التقيته أنا في الإسكندرية- وبينما كنت أهم بسرد تفاصيل القصة، قاطعني غسان قائلًا إنه “طبعا يعرفه”، وزفّ لي البشرى: فؤاد نجح في النجاة عبر البحر فعلًا، ووصل إلى أوروبا كما كان يخطط. قفز قلبي فرحًا كأن رابطة دم تجمعني بفؤاد، وفكرت في أن ذلك احتمال وارد. ألم تكن مصر وسوريا دولة واحدة لثلاثة أعوام؟ ألم أقرأ لقب عائلتي على لافتات عدة في القدس وفي دمشق وفي عمّان وفي بغداد؟ ألم أجد غسان يحفظ كلمات أغنياتي المفضلة لسيد مكاوي وللشيخ إمام ولمارسيل خليفة عن ظهر قلب ويدندنها معي؟
أفكر أن ما يجمعني بسوريا وفلسطين ليس الانخراط في السياسة وقضايا الثورة والتحرر فحسب. بل تجمعنا مشاعر أعمق؛ نتاج كثيف لتجارب إنسانية مشتركة متعددة الأوجه. ربما ما يجمعنا هو إرث أجيال حملت مآسي الشرق، ممزوجة بالموسيقى والضحك والدموع والحنين وقصص الحب وطعم الرمان ورائحة الياسمين. نتقاسم توق جماعي للحظات فرح يمكن أن تبرق على حين غرة وتكسر وقع كل تلك المآسي، فينكشف غطاء البصر ويتجدد وهج القلب.
***
ثم تبرق لحظة صباح الثامن من ديسمبر.
أهرع لمشاهدة تسجيلات تعود لأيام الثورة الأولى. أتذكر فورًا نبوءة حرائر دمشق قبل اثني عشر عامًا: “عايشة سوريا بلاك وبلا حكمك يا أسد”. أفكر في هؤلاء النساء اللاتي أحببن زياد رحباني والغناء والحرية -مثلي-، وأرجو أن يكون القدر قد أهداهن الحياة والسلامة، حتى يشهدن الثامن من ديسمبر.
تتوالى مشاهد الاحتفالات وفتح السجون وإعادة اكتشاف الحياة واستنشاق أنفاس الحرية. تستيقظ حواس السوريين على حلم كان بعيدًا بعيدًا، ثم -في ليالٍ عشر أو في سنوات عشر- صار حقيقة. يرقص قلبي على أنغام فرحتهم، بينما ترقص مضيفات الخطوط الجوية السورية على متن رحلات العودة إلى دمشق. أتنسم أخبار بارات باب توما، وأتمنى أن أعود لزيارتها والاحتفال. أشاهد مقطع لمقاتل سوري ملتحٍ يردد بحماس أغنية “على حسب وداد قلبي” لعبد الحليم حافظ بلكنة شامية جعلتني أبتسم.
في القاهرة يحدثني الرفاق القدامى عن الخوف مما سيفعله الإسلاميون بسوريا، وعن “المؤامرة” لتخريب البلد. أطلب تعريفًا للمؤامرة وللتخريب: هل هناك تخريب أكبر من تهجير نصف الشعب وقتل مئات الآلاف قصفًا بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، وتعذيبًا على المنهج النازي؟ من حوّل الثورة السلمية إلى فصائل مقاتلة وحرب أهلية تغذت على السلاح من كل حدب وصوب؟ ينفطر قلبي وأنا أقرأ عن مساجين لا يعرفون من هو “بشار” لأنهم في سراديب السجون منذ عهد “حافظ”. وينفطر مجددًا وأنا أقرأ عن الاغتصاب الممنهج وعن أطفال -ولدتهم أمهات سجينات مغتصبات- لا يعرفون ما هي الشجرة وما هو العصفور، ولا أي ملامح للحياة خارج الزنزانة. هل هناك رعب أكبر من هذا؟
أقول لهم إن بعض من الخوف مشروع، لكن لا شيء حتمي بعد. ويبقى الناس أولًا، الناس قبل كل شيء: قبل الدولة، وقبل الحدود، وقبل الجيش، وقبل الإسلاميين، وقبل الخوف منهم. الناس الذين التقيت بعضًا منهم في الإسكندرية والقاهرة، وفي بيروت والبقاع، وفي مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأود اليوم لو بإمكاني أن أعانقهم جميعًا. أقول أيضًا إن هناك فارق كبير بين الخوف من أن تفشل سوريا، وبين تمنى الفشل لسوريا؛ وهناك في مشرقنا المنكوب من يتمنى ذلك، وربما من يسعى إليه. ربما تكون تلك هي المؤامرة.
أداعب أصدقائي القدامى وأقول “أصبحتم مثل كهول نادي الجزيرة الذين كانوا يوم ١١ فبراير ٢٠١١ يترقبون وصول الأسطول الخامس الأمريكي على مشارف مصر لاحتلالها!” أعنيها كدعابة، بينما أخشى أن بعض رفاقي القدامى قد تغيروا فعلا بمرور العمر وكثافة الهزائم.
***
أعود لأقرأ ما كتبته سابقًا حين ماتت مي سكاف في منفاها الباريسي في الخمسين من عمرها. حينها كنتُ ألوم الأمل الذي احتضنته مي حتى آخر يوم في حياتها. كنتُ قد طوّعت نفسي على اليأس واحتضان الهزائم ومحاولة الطفو فوقها. لكنني اليوم أضبط نفسي تتحدث عن تجديد الأمل، وعن معاني الحق والحرية التي يمكن أن تنتصر. أفكر في أن عدالة ما يمكن أن تتحقق على الأرض، ويمكن أن نشهدها قبل الموت.
أفكر في أن الأقدار يمكن أن تفاجئنا -مفاجآت سارة- من حيث لا نحتسب، في أن هناك احتمالات أخرى واردة لكل مساعينا ولكل القصص؛ خارج المعطيات المباشرة والحسابات الضيقة. هناك نهايات أخرى غير الهزيمة والحسرة والخذلان ممكنة.
ربما آن الأوان أن تكفكف دمشق دمعها. ربما تكتمل للسوريين فرحة لم تكتمل بعد لسواهم.
مجلة رمان
—————————
الدولة والثورة على الطريقتين اللبنانية والسورية/ وسام سعادة
تحديث 18 كانون الثاني 2025
من «اتحاد شبيبة الثورة» إلى جريدة «الثورة» ناءت سوريا في «حقبة البعث» تحت ثقل الاستخدام المفرط لمفردة «ثورة» هذا مع أن حكم البعث فيها استولى على السلطة بانقلاب العسكر، بعيداً عن أي دور حيوي فعلي للجماهير الشعبية. دستور 1973 يعجّ بهذه المفردة. ينص على أن «الثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية». يشدد على «توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد». يعرفها بأنها «الثورة العربية المعاصرة ضد التسلّط والاستغلال». يحدّد ما يتميّز به حزب البعث بأنها «أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح». كل هذا في مقدمة دستور، وليس في منشور حزبي. أما المادة 11 فتنيط بالقوات المسلحة «حماية أهداف الثورة». الدستور نفسه يشدد على أن «الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً». ليس من البديهي بعد كل هذا أن تُستَصلح المفردة ذاتها، «الثورة» لتوجيهها بدءاً من عام 2011 ضد النظام البعثي – الأسدي، وقد ارتبطت هذه المرة بديناميات شعبية انتفاضة واسعة واجهت آلة البطش والرعب.
الطريف أنه يوم استبدل دستور حافظ الأسد هذا عام 2012، وفي سياق القمع الدموي، لم ترد مفردة «ثورة» في الدستور الجديد، الذي عرف عن نفسه أنه يأتي «تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات».
بخلاف سوريا، لم ترد مفردة «ثورة» في الدستور اللبناني. لم تغب في الخطاب السياسي في المقابل. كان حديث عن ثورة بيضاء ضد بشارة الخوري، وعن «الثورة» الممتزجة بمناخ الحرب الأهلية، ضد كميل شمعون. أما شعار الخمينيين المحليين منتصف الثمانينيات عن «الثورة الإسلامية في لبنان» فسرعان ما اكتفي منه بحد «المقاومة الاسلامية». في المقابل، تأرجح توصيف حشود 14 مارس 2005 المطالبة بمعاقبة قتلة رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري وحشود الشهر الجماهيري الحافل بدءاً من 17 أكتوبر 2019 بين «انتفاضة» و«ثورة».
اليوم، يطرح مآل سرديات «الدولة والثورة» في البلدين. يحيل هذا في الأساس على عنوان كتاب لينين عشية الانتفاضة البلشفية. في تصوره، الثورة لا تنتهي مع الاستيلاء على السلطة. عليها تفكيك جهاز الدولة القديم وبناء جهاز جديد. المزعم في الكتاب أن الجهاز الجديد ينبغي أن يكون أقل بيروقراطية من الجهاز القديم، وليس فقط غير مرتبط بقمع الكادحين، ومرتبط بقمع أعدائهم. في الوقت نفسه، يمهد الكتاب للمشكلة التي ستصيب المجتمع السوفياتي كله، فلينين يطرح فيه شعار «تحويل الجميع لبيروقراطيين لزمن ما» أي كل مواطن بيروقراطي في جزء من نشاطه، «لكي لا يستطيع أحد بسبب ذلك أن يصبح بيروقراطياً». يشجب مسلك «الخشوع الخرافي أمام الدولة» والإيمان الخرافي بالبيروقراطية» ويتهم أبرز منظري الماركسية الألمانية، كارل كاوتسكي بهما.
لنتأمل في واقع الشعارات والسرد في سوريا ولبنان اليوم.
في لبنان، الرئيس الجديد جوزيف عون يلخص المرحلة بأنها انتقال من حقبة «المقاومة» إلى حقبة «الدولة». وثورة المجتمع المدني تجد نفسها في هذا، مع أن الرئيس قادم من العسكر. أساساً، كان مفهوم الدولة هو شعار الثورة المدنية في لبنان. أما المقاومة فكانت تعويضاً عن امتناع الثورة الإسلامية في هذا البلد.
في سوريا. رئيس الإدارة الجديدة يتناول ثنائية الدولة والثورة من موقع أن الثورة تنتهي بسقوط النظام الذي ثارت عليه، على أن يعاد بناء الدولة بعد ذلك. في الوقت نفسه يسند سلطته إلى نوع من «الشرعية الثورية» في غياب الإطار الدستوري الممأسس لها. «على يساره» تجد من يرى أن الثورة لا تنتهي إلا بتحقيق أهدافها في بناء النظام الديمقراطي المنشود وليس فقط في إسقاط النظام الديكتاتوري. وعلى يمينه من يريد القول في الوقت نفسه أن «الشعب يريد تحكيم الشريعة» وبالتالي جدلية الثورة والدولة يجد أن تصبو إلى تحقيق هذا المراد. هناك بالمحصلة ثلاثة أفكار في سوريا اليوم. إعادة بناء جهاز الدولة البيروقراطي والعسكري والديبلوماسي الخ، تشكيل نظام دستوري، تحكيم الشريعة. هل يمكن الرهان على تقديم مهمة إعادة بناء الجهاز أولا ثم النظر في أمر النظام الدستوري وما يمكن استيعابه وما لا يمكن من مقولة «تحكيم الشريعة»؟ أم أن الأمور ذاهبة نحو «تجريب» التخليط بين الحوكمة، بما تعنيه من شبكة كفاءة وفعالية وثقة بآليات تسيير الشؤون العمومية، وبين الحاكمية، أو دعوى تحكيم شرع الله وحده، بما تعنيه من نفي صلاحية التشريع عن الإنسان؟ هل «قدر» ثنائية «الدولة والثورة» على الطريقة السورية أن تفضي إلى ثنائية «حوكمة وحاكمية»؟
كاتب من لبنان
القدس العربي
——————————-
الشرق الأوسط الجديد بعد سقوط الأسد/ مالك العثامنة
ما تحتاجه المنطقة هو كسر قوالب الوضع الراهن
آخر تحديث 18 يناير 2025
دون الخروج من صندوق “الوضع الراهن” بل وتكسيره، فإن ما يعرف بالشرق الأوسط مقبل على خراب كامل وشامل لأجياله القادمة، حتى التسمية التي فشلت طوال عقود في تحديد واضح لجغرافيا الإقليم، فكانت تتمدد شرقا حتى باكستان أحيانا، وغربا لتشمل شمال أفريقيا، أو تضيق لتحاول باحتواء مضغوط “ويائس غالبا” تحديد الشرق الأوسط حيث جغرافيا وتاريخ بؤر الأزمات العنقودية المتوالدة والمتوارثة دوما.. تلك التسمية صارت منتهية الصلاحية.
كنت دوما أتبنى تسمية اصطلاحية جديدة مختصرها “شرق المتوسط” لأن مفاتيح العلاقات الدولية تغيرت، ومنظومة تحالفات الإقليم من هلاله الخصيب (مشرقه العربي سابقا) و”دول مجلس التعاون الخليجي” امتدادا نحو مصر غربا وهضبة الأناضول شمالا، قررت تغيير أوانيها المستطرقة لتأخذ شكلا جديدا ومختلفا تماما، يحاول تحدث لغة الزمن الراهن بتغيير الوضع الراهن.
الشرق الأوسط يقف على أعتاب تحولات جذرية، خاصة بعد سقوط النظام السوري، الذي شكل محورا رئيسا للصراعات الإقليمية والدولية لعقود، هذا السقوط يمثل لحظة فارقة في إعادة صياغة ملامح المنطقة، ويفتح الباب أمام المملكة العربية السعودية، لتأدية دور محوري جديد في رسم مستقبل الإقليم.
السعودية، التي تعد القوة الاقتصادية الأكبر في المنطقة، تمتلك فرصة ذهبية لقيادة مشروع تكاملي شامل يعيد ترتيب الأولويات الإقليمية على أسس جديدة، فمع التغيرات الجيوسياسية الراهنة بات واضحا أن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، يكمن في بناء منظومة تعاون اقتصادي وسياسي، تقودها قوى رئيسة مثل السعودية، هذه المنظومة أصبحت ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة.
السعودية تُعتبر اليوم أكثر الدول قدرة على التأثير في مواقف واشنطن وليس العكس، وقد برزت استقلالية القرار السعودي في كثير من الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من دورها المحوري في إعادة تشكيل سياسات المنطقة.
بالنسبة للمملكة الأردنية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة دورها الإقليمي بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة. فهي بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي كجسر بين دول المشرق والخليج، يمكن أن تكون شريكا رئيسا في مشروع التكامل الإقليمي، ومع ذلك، يتطلب هذا التوجه وعيا استراتيجيا بأهمية الانخراط في رؤية شاملة تقودها السعودية، حيث يشكل التعاون مع المملكة فرصة لتعزيز الاستقرار، وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة.
سقوط النظام السوري ليس مجرد حدث عابر، بل هو نقطة تحول في موازين القوى الإقليمية. فإيران التي كانت تعتمد على النظام السوري كحليف استراتيجي، تجد نفسها الآن أمام تحديات كبيرة مع تراجع نفوذها في المنطقة، هذا التراجع يفتح المجال أمام دول الإقليم، وعلى رأسها السعودية، لإعادة ترتيب التحالفات وبناء توازنات جديدة، تقوم على المصالح المشتركة بدلا من الصراعات.
وتركيا، التي تعد لاعبا رئيسا في المنطقة، قد تسعى لتحقيق مصالح تتعارض مع أي مشروع لا تقوده أنقرة، ورغم ذلك، فإن التقاطعات في المصالح معها، تبقى ضرورية في المرحلة الراهنة لبناء شرق أوسط جديد أكثر استقرارا، والعمل مع تركيا يجب أن يتم بحذر مع مراعاة تحقيق التوازن بين التعاون وتجنب التبعية.
ما تحتاجه المنطقة اليوم هو كسر قوالب الوضع الراهن التي أثبتت فشلها لعقود، التحالفات القديمة والأنماط التقليدية في إدارة الأزمات لم تعد صالحة للتعامل مع تحديات العصر، بدلا من ذلك، يجب تبني رؤية جديدة تقوم على التعاون والتكامل، حيث يمكن لدول مثل السعودية والأردن ومصر، إلى جانب دول الخليج الأخرى، أن تؤسس لنموذج إقليمي مختلف يُعلي من شأن المصالح المشتركة.
في السياق ذاته، يشكل التعنت الإسرائيلي، المتمثل في سياسات اليمين المتطرف، خطرا كبيرا ليس فقط على استقرار المنطقة بل حتى على مصالح واشنطن والغرب بشكل عام، هذا النهج الإسرائيلي المتشدد يعيق أي فرصة لتحقيق سلام مستدام، مما يتطلب من المجتمع الدولي ضغطا أكبر لإحداث تغيير حقيقي، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق توازنا يخدم المصالح الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، فإن انتخاب الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يمثل بادرة أمل واضحة حيث يعكس هذا التطور تغييرا جوهريا في أدوار القوى الإقليمية، وكان للحضور السعودي الإيجابي دور بارز في فكفكة الوضع المتيبس في لبنان مما فتح آفاقا جديدة من الاحتمالات، التي يمكن البناء عليها لتعزيز الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني من أزمات متراكمة.
إن التغيرات الدولية الراهنة تفرض على الشرق الأوسط لغة جديدة في إدارة العلاقات الدولية، لا يمكن لدول الإقليم أن تستمر في العيش بمعزل عن المتغيرات العالمية، بل عليها أن تتبنى سياسات أكثر انفتاحا وواقعية، تتماشى مع روح العصر. فالسعودية، بما تمتلكه من ثقل اقتصادي وسياسي، مؤهلة لقيادة هذا التوجه، ولكن نجاح هذا المشروع يعتمد على استجابة دول الإقليم الأخرى واستعدادها للانخراط في منظومة تكاملية حقيقية.
المجلة
—————————-
سوريا: مصنع الوحوش وعقيدة صيدنايا/ علي نعناع
تحديث 18 كانون الثاني 2025
شهدت سوريا بروز نوع جديد من السياسة الحربية، تلك التي يمكن أن نسميها «التوحيش»: قصف عشوائي ومستمر للمناطق السكنية، التي تقع خارج سيطرة الدولة السورية بطريقة غير مبررة عسكريا، والتسبب بمجازر بشكل شبه يومي على مدار سني الحرب. تدمير كل المنشآت الحيوية واستعمال أسلحة وتكتيكات حربية تسعى لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وبأكثر الطرق وحشية. يذكر مثلا استخدام البراميل المتفجرة التي تبلغ دقتها صفر في المئة تقريبا، والغارات المزدوجة على المشافي والمخابز، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المناطق المدنية.
بعيدا عن القصف الجوي، تضاف المجازر التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفائها على الأرض وبشكل مباشر عبر الذبح والحرق وأشكال أخرى من القتل الوحشي غير المبرر. لم تكن تلك الممارسات وليدة الحرب السورية الأخيرة، فهي تطور لسياسة ميزت النظام السوري عبر سنوات حكمه. يمكن تلخيص المثال الأعلى لتلك السياسة في سجن صيدنايا، بوصفه جوهر العقيدة السياسية للنظام السوري: بناء السلطة على مبدأ «باطن» مخفي عن الوعي والعقل السوري، لكنه في صلب اللاوعي السوري وكلي دائم الحضور في خياله. تسكن جوف هذا الباطن سحيق العمق، وحوش وأشكال من العذاب أبشع من أن يتخيلها أكثر العقول جهنمية. سراديب وزنازين ومتاهات لا قرار لها، ولا يعرف طريق لها، لكنها حاضرة تماما في المخيلة السورية وسكانها الشبحيون سكان دائمون في اللاوعي الجمعي للجغرافية السورية.
لا يسعى التوحيش لهزيمة الخصم المفترض، أو سحق تمرد ما بمعنى تحقيق انتصار مادي مباشر، انتصار واقعي. كما أنه ليس مجرد استفحال لأساليب الحرب التقليدية بغرض الانتقام ممن تجرأ على التمرد في وجهة السلطة المتوحشة، أو لتقديم عبرة لمن قد يفكر بالتمرد مستقبلا. ما نعنيه بالتوحيش هو ممارسة للعنف، يبلغ تطرفها وعدم تكافؤها (مع التمرد المفترض) حدا يمنع أي عقل من محاولة لفهمها أو إضفاء معنى عليها. ينطوي «التوحيش»، بالإضافة للجانب المتعلق بالعنف المباشر، على ممارسة الإخفاء والتستر. أي إخفاء ظروف حدوث الوقائع الوحشية التي تجعل تلك الوقائع «واقعية» وليست محض خيال، بل إن سياسة الإخفاء تصل في كثير من الأحيان حد الإخفاء الجسدي التام لمن وقع عليهم التوحيش، ما يجعل تلك الوقائع خيالية بشكل تام.
باختصار، تسعى سياسة التوحيش إلى نفي الصفة الواقعية عن نفسها وعن سياساتها، وخلق محكومين «خياليين» جدد عبر تلك السياسة. تدعي السلطة المتوحشة عبر تدميرها وإخفائها لمنطق أفعالها التعالي التام عن المنطق البشري لمحكوميها، فتصبح تصرفاتها وطرقها في فرض سلطتها أقرب لأفعال الآلهة التي تعصى على فهم البشر الفانين، أو مماثلة للظواهر الطبيعية البهيمية التي تعصف بالكائنات، دون أن تنطق بأي حرف يبرر كوارثها. بهذا، تصبح الدولة ظاهرة فوق – طبيعية تامة القدرة والتحكم، ويصبح المحكومون كائنات تحت – طبيعية فاقدين لأي قدرة على الفعل، حتى أدنى درجاته وهي الفهم. وتصبح العلاقة بينهم نوعا من صراع بين العمالقة البلهاء، والالهة التي تسعى لسحقهم وتطهير الأرض منهم. رغم غرابتها، لكن المقاربة الميثولوجية مناسبة هنا. فالصراع لم يحدث حقيقة، لأن العمالقة لم يكن لهم وجود أبدا. أما الدولة الفوق – واقعية فهي مطلقة الوجود. هو صراع حدث ويحدث على مستوى الخيال فقط. السلطة المتوحشة أبدية ومطلقة، أما الوحوش فهم سكان المستحيل، أي كيانات خيالية تماما.
على الرغم من ادعاء التوحيش الارتباط بالمطلق، أي بالتعالي، إلا أنه يبقى عملاً سياسيا محضا ومتجذرا بالكامل في الإطار الزمني والمكاني، وبالتالي في العالم المادي. ويمكن فهمه تماما من خلال هدفه، الذي يظهر بوضوح عند النظر إلى الواقع الذي ينتجه وإلى سكان هذا الواقع. صورة الشخص الذي تعرض للتوحش يمكن وصفها من منظورين: الأول، أنه «ذات مستحيلة»، بقدر ما نفهم الذاتية على أنها القدرة، أي القدرة على الفعل، سواء كانت القدرة على الكلام أو تكوين المفاهيم أو المشاركة في مشروع سياسي. الثاني، أنه «ذات الاستحالة»، بقدر ما تُعرَّف الذات على أنها «المتلقي»، أو كيان يتلقى بصورة سلبية ما يحدد ظروفه. وهنا تشير «الاستحالة» إلى المشهد الذي يوجد فيه هذا الشخص. إذ أنه بلا شك موجود، ولكنه لا شيء سوى الوجود البحت. إنه «الأنا عند درجة الصفر».
كما أشرت بداية، لا تسعى القوة المتوحشة الى انتصار تقليدي، بل هو تحقيق مطلق للانتصار لصالح القوة التي تمارس التوحيش، والتدمير المطلق للشخص الذي وقع ضحية له. وهو يُفهم بشكل أفضل عند النظر إليه من منظور زمني: يتحقق التوحيش ليس عندما يُهزم العدو فحسب، بل عندما يخضع كامل المجال الحيوي الذي يعيش فيه العدو ـ أي السكان ـ لهزيمة من «منظور الأبدية»، أي عندما لا يستطيعون تخيل زمن لم تكن فيه القوة المنتصرة مثبتة بشكل مطلق، لا في الماضي ولا في المستقبل. إنه انتصار يمتد ليشمل الزمن بالكامل، كما شمل المكان، ما يجعل القوة الوحشية كيانا كلي الحضور، كلي القدرة، وبالتالي إلهياً. صحيح أن الجيوش الغازية قامت دائما بالقتل والنهب واستعباد المناطق التي احتلتها. وصحيح أيضا أن الدول سعت إلى توسيع نفسها تاريخيا، إما بادعاء سلالة معينة و/أو من خلال تدمير الأرشيف والذاكرة الثقافية للشعوب المهزومة. ولكن السعي إلى والقدرة على ضرب وتشويه وقتل عدد هائل من البشر بشكل مفرط، لدرجة تجعلهم يعترفون ليس فقط باستحالة وجودهم، بل باستحالة أفق الوجود نفسه، هو ظاهرة معاصرة للغاية.
يمكن العثور على سابقة للحالة السورية في حالة «المسلمين» Muselmänner الشهيرة التي تحدث عنها الطبيب النمساوي فيكتور فرانكل في كتاباته عن تجربته في معسكر الاعتقال النازي: هم سجناء معسكرات الاعتقال النازية الذين، بسبب ظروفهم القاسية، «أصبحوا غير مبالين بأي شيء [و] تركوا أنفسهم للموت». يكمن التشابه في حقيقة أن الذات التي وقع عليها التوحيش في كلتا الحالتين قد تعرضت إلى درجات لا يمكن تصورها من العنف، ما جعلها ليس مهزومة، ولا ميتًة، بل ما هو أسوأ بكثير: وجود فارغ، بيت منار لكن «لا أحد في الداخل» (كما وصفه جيجيك). ينطبق هذا الوصف ليس فقط على الحالة النفسية للعديد من الأفراد السوريين الذين يتم تشخيصهم بشكل جماعي، باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، بل أيضا على الحالة العقلية السياسية السورية بشكل عام.
في جوهر ممارسة التوحيش – ومعيار نجاحها- يكمن الادعاء بالتعالي. تُخفي القوة الموحشة نفسها خلف حجاب من الغموض، وكأن الدولة توجد في مستوى خاص بها، يتجاوز تماما مستوى الشعب. وبهذا الشكل، فإن آليات عملها وأهدافها ومنطقها الذي يحكم هذا المستوى المتعالي يبقى بعيدا عن فهم الشعب، مثل الإله أو الطبيعة، تدّعي الدولة المتوحشة أنها تعمل وفق منطق داخلي خاص بها فقط. بطبيعة الحال، فإن ممارسات الإدماج والإقصاء المعرفي هي آليات تقليدية لفرض السلطة. على سبيل المثال، يمكن ذكر نقابات الحرفيين التي يقوم وجودها على حماية أسرار الحرفة، وبالتالي التحكم بشكل فعّال بمن يمكنه أن يصبح حرفيا، وما إلى ذلك. مثال آخر هو «اللغات المقدسة» (كاللاتينية، والعبرية التوراتية، والعربية الكلاسيكية، إلخ) حيث تحافظ السلطات الدينية على سلطتها بضمان أن يكون الحق في الفهم، وبالتالي تفسير النصوص الدينية، حكرا عليها فقط. هناك أمثلة كثيرة هنا، لكن الحقيقة تبقى أن القدرة على الكشف عن المنطق أو إخفائه، أمر جوهري لأي ممارسة للسلطة بحد ذاتها.
في حالة الذات التي تعرضت للتوحش، تكمن الكارثة في جهلها بشروط نشأتها الخاصة، لأن فعل التوحيش ينتج ذاتيات جديدة – رغم أنها ذوات عارية عند درجة الصفر. القوة هي ما يفرض أشكالا جديدة. القوة هي ما يُشكّل. أن يتم توحشك يعني أن تمر بتحول، لكن في هذا التحول، يتم تشكيلك إلى شكل يكاد يكون بلا شكل، أي إلى الذات الصفر. يكاد يصبح المرء واحدا مع «الميتا» في الميتامورفوسيس أو التحول (ميتا= وراء أو ما بين، مورفي = شكل أو صورة) وهذا هو واقع القوة، القوة الخالصة. لكن هذا غير ممكن لأن الوحش يظل ذاتا، والذات هي شكليّة، تنظيم. ومع ذلك، فهي شكليّة هشة للغاية بحيث تكاد لا تمتلك أي قوة خاصة بها. على هذا المستوى، لا يمكن أن يكون هناك منطق، ولا فهم. الذات لا تعرف شيئا. إنها تعرف أنها موجودة، وتعرف أنها تعرف، أي أنها تفكر. أهم شيء تجهله الذات الصفرية هو المنطق الخاص بها، الذي يشمل تنظيمها الخاص، وما هي قادرة عليه، والأهم من ذلك، كيف ولماذا وجدت. بقدر ما تبقى تحت ظروف التوحيش، يصبح من المستحيل على الذات المتوحشة فهم أسباب حالتها الفظيعة، أو حتى اختبارها فعليا. الواقع الوحشي لا يظهر أبدا بشكل كامل، بل يتم اختباره «مثل حلم»، مثل تجربة الموت – ولكن ليس تماما. لأن الذات تنجو من هذا الموت. ما يهم هنا هو استحالة فهم هذا الواقع لأنه لم يُختبر كـ»واقع» في المقام الأول. وبالتالي، تظل شروط السببية التي نتج عنها وجود الذات مخفية عنها.
انعدام الفهم هذا يزيد من عجز الذات الموحشة، والأهم من ذلك، أنه يرفع القوة التي تسببت في تشوهها إلى مستوى منفصل عن مستواها الخاص: مستوى الهلوسة. نعود لمثال صيدنايا (وباقي السجون السورية): في ظل الانعدام التام للمعرفة حول سجون النظام السوري، الذي يشمل حتى الجهل بأماكن وجودها، أو طرق الوصول إليها، يُفتح المجال أمام العقل السوري في محاولة تراجيدية لتعقّل تلك السجون فتغزوه أشباح صيدنايا، ويتخيل له سيناريوهات لا حدود لبشاعتها ـ لأنه فعلا رأى ما يثبت احتمالية وقوع أكثر أشكال الوحشية استحالة ـ ويبدأ فعلا بالحفر في مخيلته عبر أقبية تحت – أرضية لا نهاية لها، ويحاول بلا فائدة أن يصل إلى من فقدهم، وأن يفك شيفرة تلك الأقفال، عسى أن يخرج هذا الباطن المنحشر أخيرا إلى الضوء.
كاتب سوري
القدس العربي
————————-
أين سورية في الحسابات الاستراتيجية الصينية؟/ أحمد قاسم حسين
18 يناير 2025
منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، اتخذت الصين موقفاً منحازاً للنظام السوري، في تنافض مع مبدأ رئيسي في سياستها الخارجية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وقدّمت دعماً سياسيّاً واقتصاديّاً للنظام السوري، ما أثار تساؤلات بشأن أهدافها الاستراتيجية في المنطقة العربية. على الصعيد السياسي، استخدمت الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عدّة مرات، بالتنسيق مع روسيا، لمنع إصدار قرارات تُدين النظام السوري أو تفرض عليه عقوبات. رغم أن موسكو كانت قادرة على تحمّل مسؤولية تعطيل القرارات بمفردها، إلا أن الصين شاركت في هذا الجهد، ما يعكس رغبتها في تعزيز دورها قوة دولية مؤثرة. وقد استغلّت بكين هذه المواقف لتأكيد حضورها في المنطقة العربية في إطار سعيها إلى منافسة النفوذ الأميركي وحلفائه في المنظمات الدولية.
اقتصادياً، حاولت الصين تعزيز استثماراتها في سورية، لا سيما في مجال الطاقة، عبر شركات كبرى مثل “سينوبك” و”سينوكيم” و”مؤسسة البترول الوطنية الصينية”. ومع ذلك، ظلت هذه المحاولات محدودة ولم تحقق أية نتائج ملموسة. وعلى الرغم من أهمية الموقع الجيوسياسي لسورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، إلا أن بكين لم تتمكّن من تحقيق تقدّم كبير على هذا الصعيد. ويمكن تفسير ضعف الاستثمارات الصينية في سورية بعدّة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار النزاع وغياب الاستقرار اللذيْن شكلا عقبة رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على سورية، مثل “قانون قيصر” الأميركي والعقوبات الأوروبية التي زادت من تعقيد العمليات الاستثمارية، وحدّت من قدرة الشركات الصينية على العمل بحرية. ولعل العامل الأبرز هو ضعف البنية التحتية والاقتصاد السوري وهشاشة المؤسسات الاقتصادية السيادية في سورية، ما يجعل من الصعب تحقيق عوائد استثمارية مغرية للشركات الأجنبية، وأخيراً الهيمنة الروسية والإيرانية على الاقتصاد السوري التي قيدت فرص الشركات الصينية لتوسيع نفوذها في السوق السورية.
وعلى الرغم من التحدّيات السياسية والاقتصادية، واصلت الصين دعمها النظام السوري الذي انضم رسميّاً إلى مبادرة الحزام والطريق، التي بشرت بزيادة الاستثمارات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في 2022، العام الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية. تلك الحرب التي أسهمت في تعزيز الرؤى التي تشير إلى أفول النظام الدولي آحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة، وصعود الصين قوة عالمية منافسة. وجاء هذا الصعود في سياق تقارب استراتيجي محتمل مع دول مثل روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وربما انضمام دول أخرى إلى هذا التحالف الناشئ. في هذا الإطار، زار الرئيس المخلوع بشار الأسد الصين عام 2023، حيث جرى توقيع اتفاقيات التعاون في مجالات الاتصالات والطاقة الشمسية. لكن هذه الاتفاقيات بقيت حبراً على ورق، من دون خطوات تنفيذية ملموسة. واليوم، بعد سقوط النظام السوري وسيطرة فصائل سورية مسلحة على أجزاء كبيرة من سورية، مع الإشارة إلى أن بين هذه الفصائل يبرز مقاتلو الأيغور المنتمون إلى هيئة تحرير الشام، والذين تعتبرهم الصين تهديداً مباشراً لأمنها القومي في حال عودتهم إلى إقليم شينجيانغ.
بالمقارنة مع مواقف الدول الغربية، تبدو استجابة الصين للأزمة السورية متحفظة، وغير متسقة مع طموحها المُعلن في أن تكون قوة دولية فاعلة في النظام العالمي، فقد دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشدّداً على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. وقال الوزير إن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة سورية ومن خلال حوار شامل يلبي تطلعات الشعب. ومع التحولات السياسية المحتملة في سورية، يبرز السؤال: كيف ستتعامل الصين مع الإدارة السياسية الجديدة؟ هل ستستمر في رؤية سورية منصة استثمارية واعدة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”؟ أم أن البلاد ستتحول إلى ساحة منافسة اقتصادية مع الغرب في ملفات إعادة الإعمار والطاقة؟.
تتزامن هذه التساؤلات مع توقف صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب المارّة بأوكرانيا، ما يدفع الولايات المتحدة إلى تسريع تنفيذ مشروع “الممر الهندي الشرق أوسطي” الذي يربط الهند بالخليج العربي، ومن ثم بأوروبا، في خطوة تراها الصين تقييداً لمبادرتها “الحزام والطريق”. وفي ظلّ هذه التطورات، يبقى الدور المستقبلي للصين في سورية رهناً بالتحولات السياسية. هل ستفرض القيادة السورية الجديدة “فيتو” على مشاركة الصين في مشاريع إعادة الإعمار؟ أم ستُفتح صفحة جديدة من التعاون بين الطرفين قائمة على المصالح المشتركة؟ تفيد المعطيات بأن الإدارة السياسية الجديدة في سورية قد تتبنى نهجاً يهدف إلى “تصفير المشكلات” مع القوى الدولية بحثاً عن الدعم اللازم لإعادة الإعمار والابتعاد عن التجاذبات الإقليمية والدولية. وعليه، يبقى الدور الصيني في سورية مرهوناً بقدرتها على التكيف مع واقع جديد، قد يشهد تغييرات جذرية في الخريطة السياسية والاقتصادية لسورية على نحو قد يسهم في إعادة تشكيل موازين القوى في الإقليم.
العربي الجديد
—————————————
سورية في البراغماتية الإيطالية/ بشير البكر
18 يناير 2025
قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في زيارته دمشق يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني الحالي، كلاماً مختلفاً، لم يسبق أن تردّد على لسان زائر غربي للعاصمة السورية بعد التحوّل الجديد. تحدّث وكأنه يرد على تصريحاتٍ صدرت عن وزير خارجية فرنسا ووزيرة خارجية ألمانيا في زيارتهما المشتركة سورية، والتي حملت قدراً كبيراً من الشروط والتعليمات والتوجيهات، لما يجب أن يفعله، ولا يفعله، قادة سورية الجدد، الذين أطاحوا بأحد أكثر الأنظمة وحشية. وبدلاً من أن يبادرا إلى دعم وتشجيع بلد مدمّر وشعبٍ منكوب، أعطيا لنفسيهما الحقّ في استخدام خطاب استعلائي، لا يصلح للتعامل بين الدول، بل صار من الماضي، وانتهى مفعوله مع عهود الوصاية على خيارات الشعوب التي خسرت فرنسا من جرّائها استثمارها التاريخي في قارّة إفريقيا، الذي دام عدة قرون.
تحدّث الوزير الإيطالي بلغة العارف جيداً بتاريخ منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي حضرت فيه سورية، على الدوام، في الثقافة والفكر والتجارة والحروب وتبادل المصالح والمعارف. واعتبر الوزير سورية دولة غنية بالتاريخ والروابط مع أوروبا. ولم يكن لهذه النظرة أن تصدُر إلا من موقع إدراك أن البيئة المتوسّطية غير مستقرّة في الاتجاهين، بسبب غياب آليات للتعاون والتنسيق، ولا يمكن لذلك أن يجري إلا على أساس من الندية والتعاون القائم على الشراكة بين الضفتين، وهو المبدأ ذاته الذي كان هدف الاتحاد الأوروبي في مرحلة التسعينيات، لإقامة تكامل متوسّطي بنّاء، يحترم خصوصيات الدول في الضفة الجنوبية، ومساعدتها على تجاوز التحدّيات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم الاستقرار السياسي، والحوكمة الرشيدة، وبناء تجارب محلية، تحول دون حصول حروبٍ وموجات هجرة داخلية وخارجية. ويجدُر هنا التذكير بمبادرة برشلونة لعام 1995، التي وضعت أسساً لعلاقات إقليمية جديدة، تمثل نقطة تحول في العلاقات الأوروبية المتوسطية، وهدفت لبناء علاقات جوار جغرافي بكل ما يحمله من أبعادٍ ثقافية وأمنية واقتصادية، وكانت تطمح لتأسيس منطقة مشتركة للسلام والاستقرار، عبر تعزيز حوار في حوض البحر المتوسط، يراعي الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية بين الضفتين.
اختار الوزير الإيطالي خطاباً مغايراً للذي صدر عن نظيره الفرنسي ونظيرته الألمانية، من حيث الشكل والمضمون، فهو لم يتحدّث بفوقية أو يضع إملاءاتٍ وشروطاً مسبقة، وبرهن من خلال أسلوبه ولغته عن تفهّم عميق للحالة السورية الصعبة، وما تمليه الملفّات المشتركة من ضرورات لمساعدة هذا البلد المدمّر، كي يتمكّن من بناء مؤسّسات الدولة، التي تنهض بواجباتها المحلية والخارجية، وبدا صارماً في مسألتين مهمتين. الأولى، رفع العقوبات التي جرى فرضها على نظام الأسد البائد، والتي سقطت، منطقياً، مع سقوطه، واعتبر بقاءها عائقاً لمواجهة المصاعب الكثيرة. والثانية، بدء مسار فوري للعلاقات الثنائية، وقد وجّه دعوة لوزير الخارجية السوري لزيارة إيطاليا، من أجل إطلاق ورشة عمل إيطالية سورية مشتركة، على أساس تعهد روما بأن تكون جسراً بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي.
عندما يقول الوزير الإيطالي إن بلاده جاهزة للقيام بدور الوسيط بين أوروبا وسورية، وتشجع مرحلة جديدة تتسم بالإصلاح، يترك وقعاً مختلفاً عن تصريحات الوزيرة الألمانية التي صرّحت، في أثناء الزيارة، بأن بلادها لن تقدّم الأموال لما وصفتها بـ”المجموعات الإسلامية”. ويبرُز هنا نهجان مختلفان: الأول منفتح يتّجه إلى التعاون المتكافئ، والثاني ينحو إلى فرض الوصاية، في محاولة لاستثمار الأوضاع الصعبة الناجمة عن الدمار الكبير الذي خلّفه حكم عائلة الأسد المديد، من أجل فرض أجنداتٍ غرضها إضعاف سورية، ومصادرة قرارها المستقل، وتحويلها إلى دولة تابعة، تتلقّى التعليمات من بعض الدول الغربية.
العربي الجديد
—————————-
كيف سنكتب اسم الحرية؟/ ممدوح عزام
17 يناير 2025
لم يحدث في التاريخ المعاصر للسوريّين أن نالوا الحرية، كما يحدث لهم اليوم، فجيلنا، نحن الذين كنّا صغارا حين استولى حزب البعث على السلطة، لم يكن يعرف معنى الحرية، بالمفهوم السياسي، أو الحياتي، أو الفكري. كانت حريّتنا تتجلّى في أن يسمح لنا الوالدان بالّلعب الحرّ، أو التنزّه، أو السباحة في النهر أو البحر أو المستنقعات أو البرك التي تشكّلها أمطار الشتاء، بينما أدركت الشيخوخةُ الجيل الذي يكبُرنا قليلاً، وكان قد استمتع لبضع سنواتٍ بحريةٍ محدودة في الزمن الفاصل بين سقوط ديكتاتورية أديب الشيشكلي 1954، وقيام الوحدة السورية المصرية 1958: انتخاباتٌ حرّةٌ، وبرلمان متعدّد الأصوات، وصحافة سياسيّة وأدبية وفكرية.
ومن المفارقات في حياتنا أنّنا بقينا طوال السنوات الستين السوداء، نتغنّى بتلك الحقبة العسلية القصيرة في حياة البلاد. بضع سنواتٍ فقط شكّلت فارقاً. ثمّة من يُضيف أنّها كانت الحقبة التي نشأت فيها الصناعات السورية المعروفة، عالميّاً، مثل النسيج والزجاج، وأنّها كانت بمعنى ما بداية نشوء بورجوازية وطنيّة يمكن أن تتمكّن من إرساء أساس متين لدولة مستقلّة، تدخل العالم الحديث من أبوابه كلّها.
بينما لا يعرفُ الجيل الذي ولد في زمن البعث، منذ عام 1963 حتّى اليوم، أي معنى للحرية. كانت الحرية تربضُ في شعار الحزب، كما لو كانت قيداً، أو أغلالاً، تشير إلى الاحتمال الراجح الذي عبث ببلادنا، وانقلب إلى خنجرٍ قتلٍ لكلِّ من يطالب بأية حرية. لا حرية للتنظيم، لا حرية للتعبير، لا حرية للكلام، لا حرية للصحافة، لا حرية للأحزاب، لا حرية للتجمّعات، لا وجود إلا لحزب واحدٍ قائد يمنع الأرزاق أيضاً فوق مصادرة الحريات، ويهبها بحسب قرب السوري أو بعده، عن جهازه التنظيمي الذي راح يتضخّم حتى صار غولا أو ثقباً أسود يبتلع كل شيء في بلادنا.
حريته في أن يضطهد ويقهر السوريين. حريّته في أن ينهب أموالهم، ويعتقلهم، ويقتلهم. حريّته في أن يلاحق أقرباء وأصدقاء وأصحاب من يعارضه، بعد نفيه من البلاد. هذه هي حريّة البعث، التي انتقلت إلى وراثة آل الأسد.
كنت أبحثُ في مكتبتي وأقرأ الكتبَ التي تتحدث عن الحرية، من ستيوارت مل إلى إيزايا برلين إلى زكي نجيب محمود وتشومسكي وقصيدة بول إيلوار: كتبتُ اسمك، وغيرهم. يشبه الأمر حال المتسوّلين الواقفين على أبواب المآدب. ثمّة من يستمع بالمأدبة إذاً، وثمّة من يشتهيها.
الحقيقة التي أرى أنَّ علينا عدم السكوت عنها هي أنّنا جميعاً شاركنا في صناعة القيود. لقد رضخنا طويلاً وكثيراً لحكم الطغاة، بينما كانوا يجدلون الحبال لتقييدنا. رضينا أن يكمِّموا أفواهنا بحجّة أنّهم يحرصون عليها من أجل أن نستطيع تناول الطعام. قبلنا أن يمنعونا من الكلام ومن الغناء بذريعة أنَّ السكوت من ذهب. ويمكنُ أن تزوّر الحقائق الفلسفية وينصح بفهم الضرورات لتقييد الحريات. وهكذا جعلوا من السوري شريكاً لهم في الرضا بانتزاع حريته. ووضعوا قوانينهم وزعموا أنَّ حريّتنا تكمن في طاعتها، عندما كانوا ينتهكونها هم أنفسهم.
كيف سنكتب اسم حريتنا اليوم؟ أكثر المواقف شجاعة هو الحفاظ على الحرية. أكثرها نفعا هو احترام حرية الآخر، وأشدّها قوةً هو أن نؤسِّس معاً لحريات عامّة تستطيع الثبات والمقاومة.
* روائي من سورية
العربي الجديد
————————–
سوريون معارضون للأسد…يخوّنون يارا صبري وجمال سليمان/ مصطفى الدباس
السبت 2025/01/18
أمضت الممثلة السورية يارا صبري أكثر من 13 عاماً في المنفى بعد وقوفها إلى جانب السوريين في ثورتهم ضد نظام الأسد، وتحدثت طوال سنوات عن قضايا اللاجئين والمعتقلين والمغيبين قسراً وفضحت انتهاكات النظام وقصفه للمدن والقرى ومخيمات اللجوء، وغيرها. لكنها اليوم تجد نفسها فجأة هدفاً لخطاب التخوين من الفئة السياسية نفسها التي دافعت عنها، بشكل غير مفهوم، لأن شخصية مثلها يجب أن تلاقي الثناء والشكر على موقفها الأخلاقي ودفاعها عن الحرية والديموقراطية.
وقصة صبري ليست الوحيدة هنا. فمع سقوط نظام الأسد، شهدت سوريا عودة العديد من المعارضين من المنافي، من سياسيين وباحثين ومفكرين وناشطين وممثلين، عادوا على أمل المساهمة في بناء سوريا جديدة. لكنهم قوبلوا بحملات تخوين وتشويه سمعة لا تختلف كثيراً عن ممارسات النظام السابق، لمجرد إبداء آراء، أو بعد سرد تصوّرهم لسوريا المستقبلية، كدولة علمانية مدنية.
وأصبحت صبري هدفاً لحملات تشويه ممنهجة، وتعرضت للهجوم بسبب منشور انتقدت فيه مديرة “هيئة شؤون المرأة” عائشة الدبس، بعد تصريحاتها عن المرأة السورية، ضمن حملة أوسع من قبل نساء سوريات رفضن أفكار الدبس الإقصائية. كما تعرضت صبري لهجوم إضافي بعد دفاعها عن الممثل عبد المنعم عمايري، الذي تعرض للضرب في دمشق بتهمة “السكر وسب الذات الإلهية”. وانتشرت منشورات في مواقع التواصل تتهم صبري بأنها تستغل الثورة لتحقيق مكاسب شخصية في ظهورها الإعلامي.
يعكس ذلك نزعة نحو تشويه السمعة كأداة لإسكات أي صوت نقدي، بما في ذلك الممثلان المعارضان لنظام الأسد جمال سليمان وسوسن أرشيد، اللذان واجها أيضاً هجمات مماثلة. فاستُخدمت مقاطع فيديو أو منشورات تخوين لنشر صورة سلبية عنهم واتهامهم بما يخالف القيم المجتمعية “المحافظة” بوصفها أخلاق الأكثرية.
ونشر المشاركون في الحملة التحريضية مقطع فيديو لسليمان وهو يرقص أو يشرب الكحول، وتم وصف تلك السلوكيات التي تندرج ضمن الحرية الشخصية، بأنها غير لائقة ومنحلة أخلاقياً خصوصاً من قبل رجل رزين. والهدف منها هو تشويه سمعته بهدف إلغاء شرعيته كصوت نقدي، انطلاقاً من فكرة عدم تمثيله للأخلاق السائدة.
وانضم رجل الأعمال وصاحب قناة “أورينت” سابقاً، غسان عبود، إلى الحملة عبر منشور في “فايسبوك” من دون تقديم حجج أو مبررات واضحة: “فرق كبير بين من يحمله أهله على الأكتاف وبين من يستأجر من يحملونه عليها”. وأرفق المنشور بصورتين، الأولى للإعلامي فيصل القاسم محمولاً على الأكتاف، والثانية لسليمان في مشهد مشابه عند وصوله إلى دمشق عبر مطار دمشق الدولي. وأضاف: “أخ فيصل، فلتهنأ بمحبة أهلك ومحبتهم لك”.
هذه التصريحات والحملات تعكس حالة من الاستقطاب الشديد في المشهد السوري، بدلاً من خلق بيئة تدعم الحوار الديموقراطي والنقد البناء. وانتشرت لائحة بأسماء عشرات الفنانين المعارضين لنظام الأسد، من فارس الحلو إلى مكسيم خليل، مروراً بأصالة نصري وعبد الحكيم قطيفان الذي أمضى 9 سنوات معتقلاً في “سجن صيدنايا”، بوصفهم أشخاصاً تسلقوا على الثورة وجنوا ملايين الدولارات في الخارج، بينما كان السوريون الحقيقيون الذين حرروا البلاد من الأسد يعيشون في المخيمات في البؤس.
وتلك المقاربة مبنية على معلومات مضللة، لأن معظم أولئك الفنانين توقفت مهنتهم ولم يظهروا في مسلسلات وأفلام بحُكم وجودهم في دول مثل كندا وفرنسا على سبيل المثال.
والحال أنه لا محدد واضحاً لخطوط الحملة الراهنة، لأنها لا تصدر عن الإدارة الجديدة بقدر ما تصدر عن أفراد في مواقع التواصل. وينبع الخوف من النقد لدى هؤلاء، من التقاليد التي تقدّس السلطة وتعزز الولاء المطلق وتطلق صفة التخوين والعداء. كما ساهم النظام الأبوي الذي كرسه آل الأسد طوال عقود، في نشر نمط تقديس للشخصيات السياسية، بينما أدى سقوط الأسد إلى فراغ نفسي يسعى البعض إلى ملئه برموز جديدة، من دون مراجعة للمنظومة الفكرية التي كرّست هذا النهج، بموازاة انتعاش مفهوم العصبية القبَلية.
ووضع الأفراد في سياق تصادمي مع الثقافة العامة والأخلاق المجتمعية السائدة، هو مشكلة بحد ذاته. والحملة ضمن هذا السياق، تعني أن السوريين المشاركين في التحريض، ينظرون لفكرة الدولة والوطن باعتبار السلطة أكبر وأهم من أفكار الأفراد وحقهم في التعبير عنها، مهما كانت طبيعة تلك السلطة، سواء كانت السلطة السياسية الحاكمة أو الاجتماعية أو سلطة العائلة والدين والأعراف، وغيرها.
والحال أن شيطنة أصحاب الرأي المختلف ليست مجرد وسائل سياسية، بل تعكس ظاهرة فلسفية واجتماعية ذات تاريخ طويل. فالديموقراطية ليست مجرد نظام سياسي يعتمد على الانتخابات، بل هي ثقافة تنبع من الإيمان بالحرية الفردية والعدالة الاجتماعية.
والحملة بالتالي ليست مفاجئة لأنها تشكل انعكاساً لعقود من ثقافة قمع نشرها نظام الأسد بين السوريين الذين عاشوا ضمن مجتمع مغلق مقارنة بالمجتمعات العربية المحيطة بهم. والأرجح أنه في المجتمعات التي تعاني قمعاً مستمراً، كسوريا، يصبح النقد البنّاء هدفاً سهلاً للتشويه والتفسير الخاطئ، ويُنظر إلى هذا النقد على أنه خروج عن النسق العام وتهديد للوحدة المجتمعية أو استقرار النظام. هذا الواقع يعكس ديناميكيات الخوف في مجتمعات لم تعتَد قبول التعددية كجزء من الحياة العامة.
المدن
———————————
سيّد قطب في مكتبة النوري/ معن البياري
18 يناير 2025
كان مقترحاً حسناً، تداولناه في دمشق، مؤيّد وعبّاد وحمزة وأنا، لمّا انتهينا من جلسةٍ مع وزير الإعلام السوري محمد العمر، أن نذهب إلى مكتبة النوري، فأخَذَنا سائقُنا إليها. تم جالت عيونُنا، في الطريق، بأحياء وشوارع وميادين مُتعَبة، مزدحمةٍ بالناس وبالحافلات وسيارات الأجرة المُدهشة في قِدِمها وتواضعها، والحديث عن هذا، وغيره، يطول… دلفْنا إلى المكتبة الأشهر في سورية لبيع الكتب الصادرة محليّاً وفي الخارج (من لبنان ومصر غالباً). ومن بين كتبٍ وضعَها أصحابْ المكتبة في صدارة المعروض أمام الداخلين كتاب سيّد قطب “في ظلال القرآن”، في طبعته مجلّداً من دار الشروق القاهرية، والذي نُشر أول مرّة في 1954. بدا الأمر لنا مقصوداً، فكان استيضاحُنا ممن رحّب بنا ما إذا كان هذا جديداً من المكتبة أن تبيع هذا الكتاب، الممنوع عقوداً في البلاد، فصاحبُه، كما هو معلوم، من مؤسّسي جماعة الإخوان المسلمين التي كان حافظ الأسد يسمّيها “الإخوان المجرمين”. ويُحكَم بقانونٍ (لم يُلغَ بعد!) على كل من يُشتَبه بانتسابِه إليها بالإعدام، وأرشيف علاقة الصدام الدموي بينها وبين نظام الأسديْن طويل. ولعل سيّد قطب ما زال المفكّر الأبرز لها، وهو، إلى صفته المنظّر الأهم لأدبيّات الجماعة، أديبٌ وشاعرٌ (وناقدٌ أدبيٌّ له مكانتُه)، أعدمه نظام جمال عبد الناصر في 1966. نلقاهُ في دمشق، كأنّه يستقبلنا في مكتبة النوري، فنسأل سؤالَنا ذاك عمّ جعله هنا، فيجيبُنا صاحب المكتبة، السبعيني، بأنه أخرَجَ الكتاب، بعد سقوط نظام الأسد، من “القبو”، وبدأ عرضَه وبيعَه في العلن. وفي هذه الإفادة ما فيها من ظلالٍ كثيرة، ليس فقط في ما يتعلق بـ”قبوٍ” في الشام لم يتحرّر منه سيّد قطب إلا بتحرّر السوريين من حكم آل الأسد، بل أيضاً في أنه كتابٌ وحده احتيج أن يختبئَ في القبو. وهذا ترجيحٌ في أفهام كاتب هذه الكلمات، عزّزته جولةُ عيونِنا في العناوين الكثيرة جداً في المكتبة، أنها متنوّعة في الشعر والرواية والقصة والشريعة والتاريخ والفنون (اقتنيتُ كتاباً عن أفلام سينما)، وفي التربية والاجتماع والفلسفة، فضلاً عن كتبٍ تعليميةٍ وأخرى مقرّرةٍ في الجامعات في عدّة اختصاصاتِ، وعن كتبٍ في الطبخ والتسلية، لكنك لا تصادف كتباً في شؤون فكرية وسياسية ذات منحىً تحليليٍّ في الديمقراطية والاستبداد وبناء الدولة الحديثة، وكتباً في شؤون سورية وقضاياها، من غير التصانيف التقليدية عن تاريخ البلد ومطبخها وآثارها ومدنها.
كانت قصيرةً، ومتعجّلةً، جولةُ عيوننا في المكتبة التي تأخُذ ركنَها هذا في شارع الحجاز منذ 1969، وقد أنشأها مؤسّسها الراحل محمد حسن النوري، بعد مكتبتيْن في مطرحيْن آخرين في دمشق، أولاهما في ساحة المرجة في 1932. غير أن قلّة الوقت التي كنّا عليها لم تخصِم شيئاً من انطباعٍ عن نقصٍ ظاهرٍ في الإصدارات العربية الجديدة، لكنك ربما ستحوز “متعةً” لو لديك فائضٌ من الوقت لتتصفّح طبعاتٍ أولى أو قديمةٍ من مجموعاتٍ شعريةٍ وقصصيةٍ وأعمالٍ روائيةٍ ونقديةٍ. ومفاد هذا التفصيل بأن مكتبة النوري، وهي وكيل عدّة دور نشرِ عربيةٍ في سورية، تأثّرت كثيراً بالوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، سيّما منذ 14 عاماً، مع تراجعٍ حادٍّ في حركة بيع الكتب ومع انحسار القراءة عموماً. ولكن، إلى هذا وذاك، وغيرهما من مفاعيل تتّصل بالحال العام في بلدٍ يعاني كثيراً من بؤسٍ شديدٍ في غير شأن، كان أصحابُ المكتبة يخبّئون “في ظلال القرآن” من عيون عسَس السلطة وبوليسها ومخابراتها، وهو كتابُ تفسيرٍ للقرآن لم يحظره حكم الأسديْن لمضامينِه، وإنما لاسم مؤلفه.
لا بأس، في معرض حديثٍ مرتجلٍ هنا عن تحرّر سيّد قطب من “قبوٍ” كان فيه في دمشق، من أن يرى واحدُنا هذه الواقعة واحدةً من مظاهر هزيمة الحداثة في المشهد السياسي الراهن (ماذا عن الاجتماعي العام؟) في سورية، وقد تسلّمت هيئةٌ إسلاميةٌ متشدّدةٌ السلطة في البلد، مضادّةٌ حكماً وواقعاً للحداثة، في منظومة أولويات هذه الهيئة وخيارات التوجيه والتعليم لديها. كأن مكتبة النوري تستشعر هذا المزاج، وتُماشيه، وهي التي تحضُرُ فيها روايات إحسان عبد القدوس (مثلا)، عندما تجعل سيّد قطب في مقدّمة مستقبلينا فيها، عبّاد ومؤيّد وحمزة وأنا، في نهارٍ دمشقيٍّ كانت الشمسُ فيه حانيةً، وكنّا نتظلّلُ بدفءٍ غزيرٍ في فرح السوريين بالخلاص من الأسد.
العربي الجديد
——————————-
المرأة السورية لا تحتاج إلى “عكيد” يدافع عن حقوقها!/ نور عويتي
18.01.2025
تحول الفضاء العام في سوريا إلى مساحة لـ”العقاب” المُرتجل، إذ انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شاب مضرّج بالدماء، يقتاده عناصر من “هيئة تحرير الشام” وهو يصرخ بصوت عال: “أنا كنت عم لطش بنت”… هل يمكن معالجة مشكلة التحرّش عبر مسيرات العار؟
شهدت سوريا تغيرات جذرية في الفضاء العام بعد سقوط نظام الأسد، صحيح أن السوريين بكل أطيافهم خرجوا إلى الشوارع، واحتفلوا في الساحات، واقتحموا فروع الأمن والأنفاق السرية في السجون، لكن أيضاً ظهرت ممارسات، نتيجة غياب القانون والاعتماد على “المبادرة الفردية” و”الفزعة”، تعود إلى عصور بائدة، كـ”مسيرات العار” و”العدالة الشعبية”، حيث التهمة والحكم والعقاب يحصلان علناً من دون قانون أو قضاء، أو حتى حق الدفاع عن النفس.
أحد أبرز الأمثلة على تحول الفضاء العام إلى مساحة ل”العقاب”، هو فيديو انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب مضرّج بالدماء، يقتاده عناصر من “هيئة تحرير الشام” في سوق الحميدية في دمشق، كان الشاب يصرخ بصوتٍ عالٍ: “أنا كنت عم لطش بنت”، ومن حوله تجمهر المارة في مشهد يخيم عليه الإحساس بالخوف والذهول، استنكر بعض المارة هذه الطريقة في العقاب، في حين شجع آخرون شتم الشاب والإساءة إليه.
هذا المشهد يُعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ”مسيرة العار”، وهي ممارسة كانت شائعة في أوروبا والمنطقة العربية خلال العصور الوسطى، حيث كان يُجبر المدانون على السير عراة أو بملابس مهينة في شوارع المدينة. الهدف كان إذلالهم علنياً والتشهير بهم أمام العامة كوسيلة للعقاب الاجتماعي، الممارسة التي أُعيد إحياؤها درامياً في مشهد عقاب “سيرسي لانستر” في المسلسل الشهير “صراع العروش”، تجد اليوم طريقها إلى الواقع السوري، لتعكس تراجعاً خطيراً في مفاهيم تطبيق العدالة.
لا يقتصر المشهد على المتحرشين، بل تكرر مرات عدة مع متهمين بالسرقة، أو “شبيحة” بصورة ما، مما يعكس رهاناً على الإهانة كوسيلة للعقاب في ظل غياب القانون، وغموض أساليب تطبيق العدالة على الجنح والجرائم.
بين سلطة القانون وسلطة العار
حوادث من النوع السابق، تدفعنا إلى التفكير بالمفارقة ما بين الممارسات المستجدة والقوانين التي تم تعطيلها؛ أو عدم العمل بها، فقبل استيلاء “هيئة تحرير الشام” على مفاصل الحكم، نقرأ أن قانون العقوبات السوري يُجرّم التحرش اللفظي بعقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية، كما تنص عليه المواد 517 و518.
المشكلة إذاً، لم تكن في غياب القانون، بل في آليات تطبيقه، وفي الحواجز الاجتماعية والثقافية التي منعت النساء من الإبلاغ عن حوادث التحرش، سواء بسبب الخجل أو الجهل بوجود قانون يحميهن، أو الخوف من وصمة العار.
التوعية بحقوق المرأة، كما حقوق المواطنين في عهد الأسد، كانت توظف المسلسلات التلفزيونية، بسبب انتشارها الواسع، مثل مسلسل “عصي الدمع” للكاتبة دلع الرحبي والمخرج حاتم علي، الذي بث عام 2005، والذي سلط الضوء على قضية التحرش اللفظي، من خلال شخصية المحامية رياض، التي تتعرض لتحرش لفظي أثناء سيرها في الشارع، فتقرر التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى، متحديةً الضغوط الاجتماعية من قبل أسرتها وزملائها في العمل. لكن هل كانت معالجة الدراما للقضية كافية لنشر الوعي؟ بالتأكيد لا. بل ظلت الشوارع السورية مرتعاً للمتحرشين، وندرت محاسبة المتحرشين لفظياً.
السؤال اليوم: هل يمكن معالجة مشكلة التحرش عبر مسيرات العار؟ هل دعوات فصل النساء عن الرجال في المواصلات العامة هي الحل؟
في الوقت الحالي، الضامن الوحيد لحماية النساء يجب أن يكون اللجوء للقانون، لا الاعتماد على الرجال الذي يلعبون دور “عكيد الحارة”، ليبتكروا أساليب ارتجالية للعقاب بحق من يرتكب جريمة ضد النساء، المرأة لا تحتاج إلى وصي، ناهيك بضرورة الحذر من اللجوء إلى الأعراف الذكورية ومفاهيم “الشرف” و”العار”، التي تكرس السلطات المجتمعية البطريركية.
لا يمكن إنكار وجود إشكاليات كثيرة في الدستور السوري الذي تم تعطيله، وبقوانين الجنايات والأحوال الشخصية، ولا سيما في المواد التي تتعلق بحقوق المرأة وحمايتها، إلا أن الممارسات الحالية تمثّل تراجعاً كبيراً، يُعيد النضال النسوي إلى نقطة الصفر؛ فالفيديو الذي يظهر فيه رجال يعتدون على شاب تحرش لفظياً بفتاة، يُعيد النساء إلى خانة العرض والشرف، اللذين يتوجب على الرجل حمايتهما، ويضع المرأة في إطار الوصاية المجتمعية، بدلاً من الاعتراف بها كفرد مستقل قادر على الدفاع عن نفسه، ضمن إطار قانوني عادل، لا يضعها تحت وصاية الرجال.
المرأة “الشيء”!
يزيد من المخاوف حول حقوق النساء، ما نشهده في الشارع السوري اليوم من ممارسات تسعى إلى تشييء المرأة؛ التي باتت تواجه يومياً منشورات وحملات، تسعى إلى إقناعها بارتداء الخمار، والاستتار خلف أغطية سوداء تمحو كل ملامحها تقريباً، لتتحول كل النساء إلى نسخ متطابقة، وينحسر حضورهن في الفضاء العام.
الحجة المستخدمة التي تبيح هذه الممارسات، تندرج تحت تعبير “مبادرات فردية”، وأسئلة مثل: “أليست هذه هي الحرية؟ ليدعُ كل إلى ما يشاء”. هذه التبريرات تكشف أن “هيئة تحرير الشام” تسعى إلى ضبط الفضاء العام جندرياً، عبر إباحة المبادرات الفردية، التي تقابَل بانتقاد شديد، وإلى الآن ليس هناك قانون واضح بخصوص الحجاب الإلزامي، فالأمر دعوي أكثر منه إجباري.
الشأن الذي يقال إنه سيقنن، هو التوزيع الجندري في حافلات النقل الداخلي، حيث يتم إجبار الرجال على الجلوس في المقاعد الأمامية والنساء في المقاعد الخلفية، وبرغم أن بعض النساء أعربن عن ارتياحهن لهذا القرار، نظراً لمعاناتهن السابقة من التحرش في وسائل النقل العامة، لكن القرار يحمل أبعاداً أعمق تتجاوز مجرد توفير مساحة آمنة للنساء، ليعكس سياسة تهميش ممنهج تسعى إلى تقليص حضور المرأة ومكانتها الاجتماعية.
هذا الإجراء الذي تم الحديث عنه في سياق تصريح خاص لجريدة “القدس العربي”، جاء فيه أن: “مسؤولاً رفيعاً في الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق/ زاجل للنقل، كشف عن توجه خلال أيام قليلة لتطبيق الفصل بين الذكور والإناث، في باصات النقل الداخلي العامة والخاصة في العاصمة السورية”.
بصورة ما نحن لسنا أمام قرار رسمي، بل ربما مبادرة من “شركة خاصة”، وعادة هكذا “مبادرات” يمنعها القانون، لكن تكريسها، أو حتى قبولها اجتماعياً، يقارب الفصل العنصري، بل ويجعل “كل” الرجال متهمين، و”كل” النساء ضحايا لا بد من حمايتهن بعزلهن بعيداً.
إن حل مشكلة التحرش لا يتم عبر تطبيق سياسات تُعمّق الفجوة بين الجنسين وتعزز الهيمنة الذكورية، إنما يتم عبر وضع قوانين صارمة لمكافحة التحرش، جنباً إلى جنب مع نشر التوعية المجتمعية حول أهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم، وتشجيع النساء على المواجهة والدفاع عن أنفسهن.
ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الواقع الحالي؟ وكيف يمكن للنساء التجرؤ على الإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرضن له من أزواجهن أو عائلاتهن، بينما السلطة ذاتها تمارس العنف ضدهن بدعوى “التأديب”؟ وكيف يمكن للمرأة أن تلجأ إلى نظام قانوني يُشرف عليه وزير عدل سبق أن ظهر في مقاطع موثّقة، وهو يشرف إعدامات ميدانية بحق نساء في إدلب؟
صحافية فلسطينيّة سوريّة
درج
—————————
“السلام عبر القوة”.. ماذا كان يقصد ترامب؟/ د. عمار علي حسن
18/1/2025
في إعلانه عن وقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: “سنواصل الترويج للسلام عبر القوة في المنطقة، والبناء على زخْم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقات السلام”، ليفتح بهذا قوس أسئلة لن يُغلق في المستقبل المنظور عن إمكانية فرض السلام عنوة، وما إذا كان هذا المسلك القسري سيفيد “ثقافة السلام” أم سينتهي إلى تمهيد الطريق لحرب جديدة؟
ابتداء، لم يعد أحد من الساسة والمفكرين العرب الذين نادوا بالسلام وتحدثوا على مدار العقود الماضية عن ترسيخ ثقافته، قادرًا على تجاوز صعوبة العودة إلى مثل هذا الطرح مع “الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلال إسرائيل جزءًا من أرض سوريا، وإعلان نواياها البقاء في شريط حدودي من جنوب لبنان، وما أبداه بعض أعضاء ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالي عن نية التهجير القسري لأهل غزة والضفة الغربية، ورفض “حل الدولتين”، بل والإيغال في استعارات دينية عن “إسرائيل الكبرى” التي تمتد في مخيلة اليهود المتشددين من النيل إلى الفرات.
طوال العقود الماضية، كان أصحاب هذا الطرح يتكئون مرة على رؤية عامة ترى أن السلام ممكن مهما طال أمد الحرب، كما تدل التجربة المصرية- الإسرائيلية، وأخرى تستند إلى القانون الدولي والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص “الصراع العربي- الإسرائيلي”، وثالثها طرحها أتباعها في إطار ما وصفوها بـ “الواقعية السياسية” إذ إن إسرائيل امتداد لمشروع غربي في المنطقة، ولذا فإنَّ حربًا ضدها هي في حقيقتها حرب ضد أغلب الحكومات الغربية.
وانطلقت حديثًا تصورات أخرى مثل ذلك الذي يتحدث عن الإخوة الإنسانية المحمولة على رؤية دينية عن “الأديان الإبراهيمية”، وأخرى ذات طابع سياسي يقوم على أن “تطبيع العلاقات” مع إسرائيل وطي صفحة “الصراع” إلى الأبد فيه فوائد للطرفين.
وكان أحد مداخل تسويق هذا كله، من أدناه إلى أقصاه، هو أنه الطريق الأقصر والأسلم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وإعلاء مصالح بعض الأقطار العربية في الاقتصاد والأمن، وتفرغ دول الطوق للتنمية، وكسب رضا الغرب.
وبنى هؤلاء على ما كان قد انتهى إليه الصراع مع إسرائيل إلى توقيع اتفاقات سلام مع مصر 1979، والأردن 1994، ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993، وإقامة علاقات دبلوماسية وأخرى قنصلية وتجارية مع دول عربية عدة، ووجود تنسيق أمني بين تل أبيب وعواصم عربية فيما يسمى “مكافحة الإرهاب”، وقبله كانت القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 قد تبنت السلام خيارًا إستراتيجيًا، وأبدت الاستعداد لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، شرط انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وهي المبادرة التي راكمت على ما جاء في قمم أخرى سبقتها، تحديدًا منذ عام 1996، عن السلام العادل والشامل.
ووجد في مقابل هذا طرح إسرائيلي عن التعاون، طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل شمعون بيريز حول علاقات اقتصادية مستدامة بين إسرائيل والدول العربية، تحت لافتة “شرق أوسط جديد”، وحديث بعض اليسار الإسرائيلي عن سلام مع العرب، مثلما تجلى في رؤية “حركة السلام الآن”، وبدْء تواصل مع مثل أصحاب هذا التوجه، بلغ ذروته في “إعلان كوبنهاغن” الذي صدر في 30 يناير/ كانون الثاني 1997، عقب اجتماع عدد من الساسة والكتّاب من مصر، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكان بمنزلة أول تطبيع شعبي في تاريخ الصراع، وإن كان قد اقتصر في الحقيقة على بعض النخب، وواجه انتقادات لاذعة من معارضيه في كل البلدان العربية الثلاث، وغيرها.
وعلى مدار عقود لم يستطع أي من العرب الذين تحدثوا عن السلام تجاوز عبارات حملت مبادئ رسخت في الأدبيات السياسية العربية، وهي: “السلام العادل والشامل” و”الأرض مقابل السلام” و”استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، وحملت التصورات التي سوّقت تطبيع دول عربية مع إسرائيل، فيما بعد، ظلال هذه المبادئ، إذ لم يكن أحد بوسعه أن يقفز على المسألة الفلسطينية قفزًا سريعًا، أو يدير لها ظهره كلية.
وتعاملت أجيال من الشباب العربي، بمن فيهم فلسطينيون، مع السلام، الذي اتخذ تركيبات لفظية مجازية من قبيل “مسيرة السلام” و”عملية السلام” و”التسوية السلمية”، على أنه مسألة ممكنة، حتى لو كان ميلادها عسيرًا، بفعل عقبات كثيرة تعترض طريقها مرتبطة في الأساس بالتسويف والتعنت الإسرائيليين، اللذين بلغا ذروتهما مع رفض تل أبيب الدخول في مفاوضات “الحل النهائي” مع السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرارها في الاستيطان، والاعتداء المتكرر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
اليوم، لم يعد من الممكن أن ينظر قطاع عريض من هؤلاء الشباب إلى السلام على أنه سيرورة ماضية في طريقها، وإن تأخر بلوغها الغاية التي تصبو إليها، وأن آخر الحروب التفاوض، وآخر الصراع التسوية، وآخر الاحتلال الرحيل عما يقع تحت وطأته أرضًا وإرادة وسيادة، بعد أن يدرك المحتل أن استمراره جاثمًا على الأرض والموارد والنفوس، صعب بل مستحيل.
فقد بان لجيل جديد أن الطاقة الحربية، والغريزة العدوانية، لدى إسرائيل لا تعبأ بشيء من انعقاد إرادة العرب في إحدى قممهم على أن السلام خيارهم، ولا بالقانون الدولي الرافض للاحتلال والإبادة، ولا بالمنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا بتلك التي تعمل من أجل السلام، مثل مؤسسة ثقافة السلام التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2000؛ بغية الإسهام في بناء وتدعيم السلام مـن خلال التفكير والبحوث والتعليم والعمل، ولا بوجود رغبة متصاعدة لدى بعض العواصم العربية بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، ولا بحديث عن الإخاء والتفاهم والتسامح وقبول الآخر، وأن إسرائيل تعرض بشكل سافر الحرب خيارًا إستراتيجيًا، وأنها تريد أن تفرض كل شيء بالقوة المفرطة، فلا أرض مقابل سلام، ولا توقف للاستيطان في الأرض التي يراها العرب، بتأييد من قرارات ومواقف دولية، المكان الذي من المفترض أن تقام عليه دولة للفلسطينيين.
هذا الجيل هو من تحمّس أكثر لفكرة مقاطعة الشركات التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي خرج للتظاهر في العالم العربي حين أُتيحت له الفرصة، وهو الذي ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت متصديًا لدعاوى التطبيع أو الاستسلام أو تشويه صورة المقاومة ومحاولة النيل من عزيمتها، وهو الذي راح يلوم بل يوبخ أنظمة الحكم العربية والإسلامية؛ لأنها لم تنهض لنصرة الفلسطينيين كما ينبغي، موزعًا نقده هذا، من حيث فلسفته؛ على حمولات إنسانية وقومية ودينية، ومن حيث نوعه؛ على اتهامات تراوحت بين التواطؤ واللامبالاة، وما بينها من درجات مثل الصمت، والعجز، والتفريط.
ما لا يمكن نكرانه أن إسرائيل لم تُعلن أبدًا أن “السلام خيارها الإستراتيجي” إذ لم يصرح أحد من مسؤوليها بهذا في أي يوم من الأيام، ولا في أي مناسبة كبيرة كانت أم صغيرة.
وحتى لو تحدثت إسرائيل عن السلام، في إطار حملات العلاقات العامة التي تجد نفسها مضطرة إلى خوضها بين حين وآخر، فإنها لا تجعل السلام خيارها الوحيد، بل تؤكد ممارساتها، وعقيدتها السياسية المتكئة على تصورات دينية ويُفصَح عنها من حين إلى آخر، أن الحرب هي طريقتها الوحيدة لحسم الأمور لصالحها، وأنها تذهب إلى السلام حين تُهزم أو تتعثر أو تُحرج دوليًا، لكنها تتعامل معه على أنه مجرد هدنة بين حربين.
وحين تضع الحرب الراهنة أوزارها، من المتوقع أن تنطلق رؤيتان في العالم العربي، حتى لو تفاوتتا في القيمة والقامة، من حيث القدرة على الإقناع وحجم الجمهور الذي سيلتف حولهما:
الأولى: يرى دعاتها أن الحرب لن تحسم الصراع، ولا بد من السلام.
والثانية: يرى أصحابها أن السلام لا يمكن أن يأتي أبدًا في ظل تبني إسرائيل الحرب وسيلة واحدة ناجعة.
لكن أصحاب هاتين الرؤيتين سيجدون صعوبة جمة في تسويق ثقافة السلام في المستقبل المنظور باعتبارها قيمًا وتصرفات تدفع الإنسان إلى قبول الآخر واحترامه والتحاور معه، لا سيما مع تصاعد نفوذ اليمين المتشدد في الحياة السياسية الإسرائيلية، وما تركته حرب “طوفان الأقصى” من أثر عميق في ذاكرة الجيل العربي الجديد، أعادت إليها الألم الذي كان أيام حروب دارت بين العرب وإسرائيل، خاصة بين 1956 و1973، وهو شعور لن تمحوه حملة علاقات عامة، قد تُطلق عقب الحرب، وتُرصد لها الأموال والأبواق، التي تريد للشباب أن ينسوا أو يغفلوا ويرضوا بالأمر الواقع.
الجزيرة
——————————–
عن مشاعر السجّان في صيدنايا/ إسماعيل حاج بكري
2025.01.18
لم ينل سجن صيدنايا ما يستحق من اهتمام بالمقارنة مع الهولوكوست، وسجن أبو غريب، وسجون الموت التي سطّرها التاريخ. وحتى لا يدخل في رفوف النسيان، ثمة ما يجب قوله مجدداً حول هذا الثقب الأسود في أذهان السوريين.
على الرغم من الفرحة الغامرة بزوال الطاغية بشار الأسد، وعلى الرغم من انتصار الثورة دون أيّ تدخلات عسكرية خارجية وتنفس السوريين الصعداء، إلا أن المشاهد التي صدرت من سجن صيدنايا ما تزال أشد وطأة علينا. إذ لم يكن الحزن نابعاً فقط من تلك المشاهد غير الإنسانية، بل أيضاً من خوفنا من أن نكون شركاء بشكل غير مباشر في هذه الجريمة.
يدور في ذهن المرء، وهو يشاهد مأساة العصر في هذا السجن، أنه قد تشارك يومًا ما الحياة مع السجّان في مدينة واحدة. هذا السجّان كان جزءاً مما يسمى “النسيج الاجتماعي”. ربما قرأنا جميعًا رواية القوقعة للروائي السوري مصطفى خليفة، ورسمنا مشاهدها في مخيلتنا، وبكينا على تفاصيلها، وعلى روح القهر التي تتسرّب من وراء النص. لكن في النهاية، تبقى القوقعة مجرد رواية، رغم إحساسنا بصدقية هذه السردية، ولا سيما أن الكاتب عاش التجربة كما هي. حين قرأنا الرواية، لم نستطع إقناع أنفسنا بواجبنا تجاهها لكونها مجرد رواية. لكن صور سجن صيدنايا كانت عين الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو الهروب من مسؤولياتنا تجاهها.
الكل على هذه الأرض رأى صوراً وفيديوهات لا يمكن لأي مخيلة بشرية، مهما عظمت، أن تتصور هذا الكم الهائل من الإجرام؛ آلات التعذيب، أساليب الإذلال، تصميم الزنزانات، السلاسل الحديدية، الغرف تحت الأرض.. جميع التفاصيل غير المنطقية التي تبدو وكأنها من أفلام سينمائية باتت الآن حقيقة لا تقبل الإنكار.
وهنا تطرح واقعة وعار سجن صيدنايا سؤالًا يهرب كثيرون منه: من هو السجّان؟ وأيّ نوع من البشر هو؟ كيف يمكن لإنسان أن يجرّد نفسه من إنسانيته ويتحوّل إلى هذا النوع من الوحوش؟ هل الإنسان بطبيعته قادر على ذلك؟ أم أن هناك أساليب تُمارس عليه ليصبح هكذا؟ هل يمكن تحميل ذنب هذا الإجرام لشخص ما فقط لأنه جاهل أو غير متحضّر؟ أم أن الظروف الاجتماعية والسياسية تلعب دوراً في تكوين هذه الشخصية؟ وهل السجّان ينتمي إلى طائفة أو دين أو عرق معين؟
أسئلة لا تنتهي لفهم هذا النوع من البشر – إن صح التعبير.
على مدى عقود، اعتمدت عصابة الأسد التي حكمت سوريا بناء السجون، وقتل وترهيب الشعب السوري، وتهجيره وملاحقته حتى في المنامات. هذه العصابة تميزت بقدرتها على تقسيم المجتمع السوري إلى قسمين لا ثالث لهما: إما سجّان أو سجين.
الجميع يعرف مواصفات السجين في سوريا، لكن من هو السجّان؟ هل له زوجة تشاركه الفراش؟ هل له والدان يدعوان له بالتوفيق في عمله؟ هل له أبناء يفخرون به ويتحدثون عن “تضحياته”؟ هل السجّان يشرب الشاي الآن؟ هل أنا أتشارك معه مشاهدة مباريات كرة القدم؟ هل للسجّان أصدقاء يخبرهم بعمله؟ هل نتنفس من نفس الهواء، نحن والسجّان؟
نعم، للسجّان زوجة تشاركه الفراش والجريمة. فهي التي تتواصل مع أهالي المعتقلين، وتطلب مبالغ طائلة من المال مقابل رؤية أولادهم لدقائق أو التحدث معهم عبر الهاتف. وأحيانًا يتم الدفع مقابل وعود بتخفيف التعذيب عن المعتقل أو معرفة مكان وجوده.
أما زوجة السجّان، المتمثل في هيئة إنسان، فزوجته تشتري الهدايا والمجوهرات والألبسة، مدعية أنها هدايا من زوجها الرومانسي الحنون. للسجّان أيضاً والدان يفخران به، ويتحدثان عنه باعتزاز، ويدعوان له بسبب مساهماته في تحسين وضعهما المادي. كيف لا، وهو الذي أجبر أحد المعتقلين على التنازل عن منزله مقابل عدم سجن أحد إخوته، وقام بإهداء هذا المنزل لوالديه لينعما بحياة أكثر رفاهية. كما قدّم لهما هدايا فاخرة من أموال جناها من تجارة الأعضاء البشرية، حيث قام مع بعض زملائه باستئصال أعضاء المعتقلين وبيعها قبل قتلهم.
للسجّان أبناء يتحدثون بفخر عن ساعات عمل والدهم الطويلة، ويذكرون اشتياقهم له عندما يضطر للعمل ليلًا. يتحدثون عن الألعاب التي يجلبها لهم، وعن الرحلات الصيفية والسهرات التي يقضونها معًا. ولكن هناك جانب لا يستطيعون قوله. وهنا، أنا أقوله بالنيابة عنهم: آخر رحلة قاموا بها الصيف الماضي كانت على نفقة عائلة دفعت مبالغ طائلة لوالدهم لتهريب ولدهم البالغ من العمر 15 عامًا، والذي اعتقل بتهمة الإرهاب والتخابر مع دول أجنبية.
والدهم أيضًا دفع أقساط السيارة التي اشتراها لابنه بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة والتحاقه بكلية الحقوق ليصبح ضابطًا، وليساهم مستقبلًا في تحسين الوضع الاقتصادي للعائلة. هذه السيارة دفع ثمنها من “اكتشافه العظيم” في السجن، حيث أجبر أحد المعتقلين، وهو مهندس كيمياء، على تصنيع المخدرات، وبهذا أصبح للسجّان دخل ثابت.
السجّان، رغم أنه شخص لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يجيد الحياة كبشر، كان يهتم بتعليم أبنائه في أفضل جامعات العالم. للسجّان أيضًا أصدقاء وأقارب يتبادلون معه الدعوات والعزائم في المناسبات والأعياد، ويقفون بجانبه في الأحزان. فالسجّان شخص يستطيع التكيف مع محيطه بشكل مدهش.
لكن الخوف الحقيقي أن يكون الآخرون، ومنهم أنا، قد تشاركنا شيئاً مع هذا السجّان، سواء في المطعم أو الحارة أو أي مكان محتمل يجمعنا معه.
أسأل دائماً: هل شاهد السجّان “الكابتن ماجد” مثلنا جميعاً، وتأثر بحماسة المباريات يومًا ما؟ هل كان يترقب حلقات “جزيرة الكنز” وفرح، مثل جميع الأطفال، حين رأى أبطال القصة يقتربون من أحلامهم؟ هل بكى السجّان من مشهد محزن في أحد المسلسلات التي أثارت مشاعره؟ أو تشارك الضحك معنا حينما شاهد لقطة كوميدية طريفة رسمت البهجة على وجهه كما فعلت معنا؟ لا أعرف حقيقة كيف هو عقل ووجدان السجّان، وأي نوع من البشر هو!
وعلى الرغم من محاولات البعض فلسفة العذاب والقهر ورشّ الفهم على مأساة سجن صيدنايا، إلا أن حقيقة السجّان أنه تربى في بيت يتألف من عائلة متكاملة، ونشأ على فكرة اقتنع بها. بل العائلة ذاتها احتضنت فكره السجاني ومجازره.
السجّان هو ابن وبنت افتخرا بوالدهما كونه مجرمًا. لديه زوجة تحدثت عن حنيته. هو مجتمع من الأقارب والأصدقاء الذين يزعمون أنهم لا علاقة لهم.
السجّان هو كل شخص كان يقول: “كنا عايشين”، وكان يرى سوريا جنة رغم الظلم والإذلال والفساد. السجّان هو كل شخص يقبل وجود سجّان في سوريا اليوم ليخيف الناس إذا طالبوا بحقوقهم أو أبدوا تخوفهم من المستقبل أو حاولوا مراقبة الوضع بحذر.
ومع ذلك، مواصفات السجّان لا تنتهي، لأنه خارج الوعي البشري الطبيعي
تلفزيون سوريا
————————
كهف أفلاطون: ظلام الأسد وأصابع سوريّة نحو الشمس والأمل/ محمد السكري
2025.01.18
عدت إلى سوريا بعد تهجير دام أكثر من 14 عاماً منذ اندلاع الثورة السورية ومثلي ككل السوريين ظنوا أن العودة غير ممكنة، فقد مثّل بالنسبة لي مشهد العودة حالة غير مفهومة كما لدى معظم السوريين غير القادرين على استيعاب ما حدث، فالجميع ما زال عالقاً عند لحظة إعلان هروب بشار الأسد نحو روسيا، التي تمثل صدمة غير قابلة للفهم، في الوقت الذي ظننا به أن الأسد حالة أبدية حقيقية وقدر سوريا هو الاستبداد وحكم هذه العائلة لسوريا.
بدت سوريا متعبة “مشحورة” بما يكفي كبلد، أما السوريون فلديهم شعور واحد بأن سوريا وأخيراً ضحكت لهم بقدر ما أحبوها، مشاعر السوريين داخل البلد مركّبة بين الانفراج والأمل بالمستقبل والخروج من مستنقع الدولة المتوحشة، وبين واقع البلاد المظلم كأي شارع سوري بعد العصر، كل من يذهب لسوريا سيلحظ أن البلاد غير موجودة وأن النظام حولها لمكان بائس بقدر بئسه هو، تشبهه بتعاسته وإجرامه وحبه وتطلعه للاستمرار بالسلطة وإن كان ذلك سيجعل البلاد أسيرة نفسها.
في شوارع دمشق، بعد سقوط النظام، ترى الناس محمّلة بهموم كبيرة مع ذلك تضحك، لأنّ الهم الأكبر قد زال وأخيراً، واندثر إلى غير رجعة، الأحاديث عن إجرام الأسد تنبض به شوارع العاصمة، الدمشقيون يشبهون كهف أفلاطون وربما المقاربة بين كهف الأسد وأفلاطون هي الأقرب لتوصيف الواقع، مع فارق بسيط هو أنّ من خرج من المغارة قد عاد حراً محرراً ولم يمت، مما أشعر الناس أن الحقيقة المطلقة التي آمنوا بها غير صحيحة وأن الأسد غير أبدي كما اعتقدوا بطابع الخوف والاستبداد والقتل، لذلك يسمي الناس ما حدث بالصدمة الإيجابية أو المعجزة، لدرجة أن الكثير من الشباب السوري ما زال غير قادر على فهم حالة الحرية التي وصلت لها البلاد وما إن كانت وهماً أو حقيقيةً سماها لي مجموعة شباب “نحن نشعر بفرط حرية غير مفهوم”.
اللافت في البلاد وسكانها، ليس فقط استمرار الخوف كجزء من حالة تشكيل شخصية “السوري” فأسدنة الفرد السوري” كانت عنوان مرحلة عمرها ستة عقود من الخوف، في الجمهورية الوراثية، حتى الناس نفسها ما زالت عالقة بين الحقيقة والوهم؛ ذات الحقيقة التي قاربها أفلاطون في نظرية الكهف بين من يريد إقناع الناس بأن هناك بالفعل شمسا ونورا وعالما آخر غير الكهف وظلامه الدامس، وبين من يريد أن يقول للناس أنهم أصبحوا أحراراً بحق.
فالقدرة على تصديق ما حدث في سوريا مازال صعباً، تحدث لي رجل حلبي عن عدم قدرته على ركل رأس حافظ الأسد بعدما سيطر الثوار على المدينة بسبب عدم قدرته على تصديق ما حدث وخوفه من عودته رغم انقضاء شهر كامل على تحرير سوريا وهروب الأسد، لذا، فإنّ المعرفة تحتاج إلى معاينة وتفكير وشك وطريق الحقيقة محفوف بالمخاطر كما يقول أفلاطون أي أن القدرة على التعامل مع حقيقة سقوط الأسد بحاجة إلى وقت كبير وطويل فإرث الاستبداد لا يمكن أن يزول بسهولة بمعنى الخوف وليس العادات والسلوكيات والأدوات فهذه بحاجة إلى تعامل مختلف وثقافة بديلة مرتبطة بالإحلال والاستبدال وهي أصعب من تجاوز فكرة الحقائق الوهمية والوصول للحقيقة الأصلية، ولا يمكن إنكار أن هناك أكثر من سوري وسورية هناك العديد من السوريين بهويات عديدة منها المتنوعة المواطنية والثائرة، ومنها تلك القاتلة سبق أن سماها جورج طرابيشي “هويات قاتلة”، ومنها متعلقة “بالقابلية للاستعباد” كما ذكرها مالك بن نبي.
في الواقع، الذي يجعلنا نشعر بالتفاؤل هو حالة الشباب السوري الذي انكب على اللقاءات والمحاضرات غير المسموحة سابقاً التي تتناول المجتمع المدني والنقابات وأدوار الشباب ومسؤولياتهم، خلال لقائي مع مجموعة شباب في دمشق وحلب يمكن لحظ الدوافع والطاقة لدى هؤلاء الشباب من أجل التغيير والتعليم وإحلال الثقافة البديلة التي تنطلق من الاختلاف والتنوع والحريات أولاً وآخراً، ولمست الرغبة ببناء الدولة والتمييز بين الحقوق والواجبات، رغم وجود تحفظات وتساؤلات كثيرة عن طبيعة المرحلة، لكن أكثر ما جعلني في حالة تفاؤل أن الناس كانت تمارس حالة الثقافة في بيوتها لدرجة كما في واقع الكثير من الشباب الحاضرين للندوات والمحاضرات والتدريبات، الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت على البلاد ويجنبها معركة طويلة للانتفال من التغييب للواقعية.
أمّا تعامل السلطات الجديدة مع ملف الحريات فهو لافت، بمعنى أن مستوى الحريات عال ولا توجد رقابة سلطوية على آراء الناس على العكس هناك مساحات مقبولة، في ظل عودة المنتديات الأدبية والمحال لتمارس دورها الطبيعي التي تشعرك كأن سوريا في لحظة عناق مع فترة استقلالها؛ قلت لزميلي أن يوما كهذا في دمشق يكاد يشعرك أنّه يوم هارب من خمسينيات القرن المنصرم؛ فقهوة الروضة الدمشقية تعج بالحوارات السياسية كذلك فندق الشيراتون والفردوس وغيرها؛ في مشهد يعيد لسوريا هويتها الذاتية لتشبه نفسها كما كانت.
لا يعني ذلك، أن المشهد السوري مكتمل، فأمام سوريا تحديات كبيرة، بإمكان الجميع سماعها في شوارع سوريا، فخلال رحلتي مع سائق تكسي في دمشق، عارض السائق ارتفاع أسعار الخبز بشكل كبير مع تراجع حركة النقل والتنقل، في ذات التوقيت ترى السوريون الذين لديهم حد مقبول من الدخل حواراتهم أكثر اختلافاً وترتبط بالتحول والانتقال السياسي ومناقشة كل حدث في البلاد بما في ذلك التطورات المجتمعية والسياسية، أمّا الأكثر رخاءً فغالب الظن أنهم يقومون بترتيب اللقاءات السياسية مع السلطة السورية الجديدة لبحث أدوراهم ومستقبل البلاد. ومنهم من يقوم بانتقاد السلطة لأجل السلطة وتثبيت هوية المجتمعات البديلة أو كما سماها أحد الزملاء “فئة ديكور المجتمع”.
بذات النسق، يمكن لحظ الاندفاع الكبير لدى المنظمات العاملة سابقاً في مناطق المعارضة لإحداث الفرق وضمان استمرار وجودها، كما أنّه من اللافت وجود حالة من الحركة المفرطة يغلب عليها طابع العمل لأجل العمل، وأخرى متعلقة بنقد العمل، مع وجود إقبال كبير لإلقاء المحاضرات والتدريبات من مختصين وغير مختصين مما يجعل الحالة الثقافية في البلاد مركبة وفيها جوانب إيجابية كبيرة لكنها بذات الوقت تحمل بعض الفوضى أو “فوضى الفراغ” النابعة عن فراغ في حالة الكفاءات داخل سوريا وانفتاح البلاد أمام مشهد جديد ومحاولة مواكبة “الترند” مع أن الثقافة كحالة لا تبنى بالتهافت.
سوريا الجديدة بلاد منفتحة على نفسها وعلى الآخر وهو أكثر ما يبعث الأمل، الجميع يتحدث عن “التفاؤل الحذر” ومنهم من يشعر أن هذه اللحظات استثنائية لن تتكرر من جديد في سوريا، وبلاد بلا عمل مدروس مفهوم وتروي وقراءة صحيحة للمشهد ومتطلبات السياق لا تبنى وإنما تغرق وتبتلع من جديد لأن عنوان المرحلة “إدارة الأولويات والفوضى” على العموم، الأجمل من كل هذا المشهد أن هؤلاء الذي تركوا البلاد وعبروا البحار للهروب منها، قد عادوا إليها ومن حب البلاد ما قتل، فيا سوريا لا تبتعلي من أحبك من جديد.
تلفزيون سوريا
————————-
العقوبات والمسار الجديد في سوريا/ أحمد عيشة
2025.01.18
مضى نحو أربعين يوماً على التخلص من نظام الأسد، الذي كان السبب الأساسي في فرض العقوبات الكبيرة على سوريا، عدا العقوبات المفروضة على شخصيات النظام التي يجب أن تبقى سارية، ولم تتخذ القوى الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي) إجراءات جدية لرفع العقوبات أو تعليقها عن سوريا بما يفتح الطريق أمام انتعاش للاقتصاد وبدء إعادة الإعمار، وإنما لجأت إلى تعليق مؤقت على بعض القطاعات منها الطاقة، ومن جهة أخرى تستمر بخطاب استعلائي يطالب هيئة تحرير الشام، القوة الحاكمة، بمزيد من الاشتراطات من دون ربط تلك الطلبات بخطة واضحة عملية، كونها مصنفة كتنظيم إرهابي وبالتالي تمنع القوانين في كل تلك الدول من التعامل معها، ناهيك عن العقوبات المفروضة على سوريا من مصادر مختلفة تنفيذية وتشريعية، وهي ما تتطلب وقتاً لرفعها.
تعاني سوريا من عدة مستويات من العقوبات: عقوبات دولية (الأمم المتحدة) وعقوبات من دول غربية مع الولايات المتحدة، وهي متوزعة على العقوبات المفروضة على النظام، التي ينبغي أن تستمر، وعقوبات على سوريا (تحت سيطرة النظام) بشكل عام، وهي الأكثر ضرراً بعملية تعافي سوريا وانتقالها، والعقوبات على هيئة تحرير الشام بسبب تصنيفها كـ “منظمة إرهابية” وعلاقاتها السابقة بتنظيم القاعدة، وفق التصنيف الغربي، ومصدر العقوبات هذه مرتبط بجهات تشريعية وأخرى تنفيذية، وبالتالي فأمر رفعها يستلزم مزيداً من الجهد والوقت، ويتلخص الجهد بالتواصل مع الجهات التشريعية والأحزاب والبرلمانات في البلدان التي فرضت تلك العقوبات، ليس فقط من قبل الإدارة الحاكمة، وإن كانت تتحمل المسؤولية الأكبر، وإنما من قبل الشخصيات المؤثرة والمنظمات والهيئيات المدنية التي لعبت أدواراً سابقة في فرض العقوبات.
صحيح أن الهيئة قادت عملية عسكرية أدت إلى التخلص من نظام الأسدية، وهو إنجاز تاريخي يجب التمسك به بكل الإمكانات المتاحة، ويتطلب منها، كونها الهيئة الحاكمة، والسعي للانتقال من الدائرة الضيقة في الحكم نحو المشاركة الأوسع، إلا أنه هناك ضرورة للابتعاد كلية عن نموذج “الجبهة الوطنية” تحت حجة تجانس فريق العمل، فرغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال كما تصف نفسها، لكنها في الوقت نفسه تشرع بتأسيس أهم نويات الدولة: الجيش والأمن، وكذلك التعليم، وبالتالي يتوجب إشراك الجميع، بمعنى آخر الانتقال من طور الجماعة ذات الأيديولوجية السلفية إلى أحد الشركاء، وليست الجهة الوحيدة في بناء الدولة، وبالتالي التخلص من عقلية دولة الجماعة والانتقال نحو دولة الأمة، دولة المواطنين المتساوين أمام القانون من دون أي تمييز قائم على الدين أو المذهب أو الإثنية، وهو ما يشكل طموح السوريين.
تتعرض الهيئة بوصفها اليوم الجهة الحاكمة لضغوط كبيرة من الخارج، وهو ما تجلى في زيارة وخطاب وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الفرنسي، حيث ظهرت الوزيرة وكأنها تقدم إنذاراً متجاوزة الدور الدبلوماسي والسياسي لها، وتصور نفسها مع غيرها من ممثلي القوى الغربية كجهة “حريصة” على بناء سوريا وتعافيها، وتتخذ من بعض المشكلات القائمة التي صنعها وعمقها نظام الأسدية، وأهمها مشكلات الأقليات الإثنية والمذهبية، إضافة إلى حقوق النساء ستاراً لخطابها المتعالي “الاستعماري”، مذكراً بمسيرة بناء الدولة السورية منذ مئة عام، وكيف قامت القوتان الاستعماريتان وقتها، فرنسا وبريطانيا، تحت ذريعة حماية الأقليات بوأد مشروع الدولة الوطنية في سوريا، وتأسيس الدويلات المعروفة.
كل هذا يفرض علينا التمسك بخطابنا الوطني وعملنا المشترك لحل هذه القضايا، فهي مشكلات تستلزم حلاً، ولا ينبغي أن تبقى سيفاً مسلطاً على رقابنا، وذريعة للتدخل وضرب إنجاز السوريين الكبير: الخلاص من الأسدية. ولسحب تلك الذرائع والانتقال إلى موقع مطالبة القوى الكبرى برفع العقوبات على سوريا والمساهمة بإعادة إعمارها ووضع سوريا على سكة التطور الديمقراطي، التي يقتضي عودة الرأسمال الوطني كحامٍ للديمقراطية من خلال التنافسية الاقتصادية التي تولد بطريقة ما تنافسية سياسية، علينا مواجهة استحقاقات مهمة وضرورية، وهي مسألة التشاركية في الحكم قولاً وعملاً، والإعلان صراحة عن تبني المشروع الوطني في بناء الدولة القائمة على القانون الذي يضمن ليس فقط التنوع الثقافي والاجتماعي، بل التعدد السياسي الذي يشكل الضامن الحقيقي للبلاد، والطريق الآمن لخروجها من مستنقع الأسدية، والبدء ببناء مكانة لسوريا بين الأمم.
ومن العوامل التي تفسح المجال للتدخلات وإنجاح مساعيها، هي الحالة المجتمعية السائدة في سوريا، تلك الحالة من التفتت التي عمل عليها نظام الأسدية من خلال سياساته الطائفية وأساليبه الإبادية التي حولت المجتمع السوري إلى ما يشبه حبات الرمال. تلك الحالة التي تشكل تركة ثقيلة لا بد من التعامل معها بحكمة من خلال خطاب وسلوك يعيد الحقوق من دون التغاضي عن المحاسبة كمقدمة للعدالة، وبالتالي رسم الملامح العامة لسوريا الجديدة، التي تفسح المجال لجميع أبنائها بالتشارك في بنائها وإدارتها، وهذا يقتضي أيضاً التفاعل بين الإدارة والجمهور، وليس الاتكال عليها، بل ينبغي العمل في بناء الحركة السياسية والمدنية من أحزاب ومنتديات ونقابات كضامن وإطار لحركية المجتمع أمام تغول السلطات التي تجنح بالعموم إلى الاسئثار بمقاليد الحكم، وخاصة في مرحلة الانتقال.
لا يمكن لسوريا التي تخلصت من أسوأ نظام لصوصي، نظام حول سوريا إلى زنازين ومقابر جماعية ومصانع كبتاغون أن تعيش على المساعدات، وهي الصيغة المتاحة حالياً لتقديم الدعم، ولذلك ينبغي السعي داخلياً وعربياً من أجل إلغاء العقوبات عن سوريا ولو تدريجياً، ورفع تصنيف الهيئة كـ “منظمة إرهابية”، وهو ما يتطلب منها مد الأيادي والتشارك مع الجميع، كونها تتجه نحو أهم عملية انتقالية في تاريخ سوريا خلال مئة عام، تأسيس الدولة من جديد، بما تقتضيه أولاً صياغة دستور جديد أو معدّل، إضافة إلى المبادئ والنواظم الأساسية التي ستؤطر تشكيل الدولة، وكيف ترى سوريا نفسها كدولة في محيطها في هذه المرحلة الزمنية (مدنية ديمقراطية أم إسلامية)؟ وكيف ستكون العلاقة بين المواطن والدولة؟
تلك أسئلة يطرحها السوريون أولاً، والعالم ثانية، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن السوريين وحدهم سيقررون ذلك سلمياً، فسوريا تعيش اليوم مرحلة انتقال سياسي، يمكن لكل خطوة فيها أن تغير مسار التاريخ، وهذا يتطلب التفاعل بين الداخل والخارج، الذي ينبغي ألا يحدث بعد فوات الآوان. وسيعتمد هذا التفاعل على اتخاذ الحكومة السورية الجديدة إجراءات تكسب دعم السوريين والدول على حد سواء، مثل الولايات المتحدة، التي سيكون دعمها ضرورياً لسوريا للتحرك في اتجاه إيجابي، وفي المقابل، ينبغي على الغرب أن يقدم خطة واضحة نحو رفع هذه العقوبات والاعتراف الدبلوماسي بهيئة تحرير الشام مقابل إجراءات والتزامات من قادة سوريا الجدد، وإذا ما تأخر الغرب، فقد يدفع البلاد نحو الانهيار ويهدر فرصة في المساعدة على انتقال سوريا من الاستبداد.
عسى أن تقدم النقاشات والحوارات والمؤتمر الوطني المزمع عقده والإدارة الحاكمة إجابات تلبي متطلبات السوريين بالعيش بحرية وكرامة وعدالة، ولا شك أن تلك الإجابات ستكون بوابة لرفع العقوبات أو تمديدها، وبالتالي بناء سوريا حرّة جاذبة لأبنائها، أو تكرسها بلداً طارداً تتجه نحو مزيد من الأزمات التي هي وغيرها من البلدان بغنى عنها، أزمات إفقار وتحارب وتهجير وتدخلات، فسوريا اليوم أمام مفترق طرق: التأسيس لدولة تحترم مواطنيها من دون تمييز وإعادة البناء والتفاعل مع العالم أو العزلة والمعاناة.
تلفزيون سوريا
—————————–
أسئلة مشروعة حول مستقبل سوريا/ د.ناصر زيدان
تحديث 18 كانون الثاني 2025
ما حصل في سوريا كان حدثاً هاماً بكل المقاييس. ولسقوط النظام تداعيات لا يمكن حصرها بعُجالة مرافقة لنشوة نصر عند البعض، ولصدمة هزيمة عند البعض الآخر، ذلك أن موقع سوريا الجيوسياسي، والدور الذي كانت تمثله، له أهمية قصوى، بينما التغييرات الكبيرة التي أحدثتها القيادة السورية الجديدة على هذا الدور ستكون هائلة، وستتأثر بها مصالح دول متعددة، وهي بمثابة انقلاب على المقاربات السابقة برُمّتها. ولسوريا خصوصية متميّزة في شبكة التفاعلات الشرق أوسطية، لا يمكن إغفالها، أو التقليل من تأثيراتها، مهما كان عليه الوضع القائم
من الواضح أن غالبية ساحقة من الشعب السوري تعاطت بإيجابية مع ما حدث، وهلَّلت للتغيير بحماسة فائقة، خصوصاً لكون العملية جرت من دون سقوط دماء كثيرة، وضحايا العمليات العسكرية التي حصلت قبل يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وبعده اقتصرت على عدد محدود جداً، قد يكون بينهم أبرياء ظلمتهم المُصادفة، كما أن عمليات الانتقام المحدودة أيضاً، لم تلقَ أيّ احتضان من المسؤولين الجُدد الذين تعاطوا بشيء من التسامُح، وأطلقوا نداءات هَدفت لانتظار الاقتصاص من كبار المُرتكبين بواسطة المحاكم والقانون، وهؤلاء يجهدون بما تيسَّر من عدّة الحُكم لكي لا تعمّ الفوضى، لكن بعض الاختلال لا يمكن إخفاؤه بالتمنيات أو بالتصريحات.
كل ذلك لا يعني في أي حال أن الأمور انتهت، وعملية انتقال السلطة اكتملت. فعلى العكس من ذلك، هناك تحديات كبيرة ما زالت قائمة، والضباب السياسي والأمني ما زال يطفو فوق سطح الحدث بين الحين والآخر، وأسئلة كثيرة تُطرح أمام القيادة الجديدة في دمشق، وهذه الأسئلة تحتاج إلى توضيحات، وإلى إجاباتٍ صريحة، من دون تجاهل للخطوات الإيجابية الكثيرة التي حصلت، وقد يكون أهمّها احتكام المنتصرين للمؤسسات الحكومية الشرعية في معالجة المشكلات المطروحة، وتجنُّب التصرفات الفئوية أو الميليشياوية في مقاربة الملفات الداخلية والخارجية.
والحكومة الانتقالية التي تدير البلاد اليوم، نجحت في ضبط الفوضى في أكثر من مرفق عام، برغم الكلام الذي رافق توليها للمهام، لكونها لم تنبثق عن انتخابات، ولا عن جهات لها مشروعيتها القانونية، وهي تتألف من لونٍ واحد من مكونات الشعب السوري، وليس فيها تمثيل مناطقي أو طائفي أو سياسي كافٍ، كما أنها لم تولد من هيكلية دستورية، ولا عن إطار ثوري جماعي مشروع، حيث لم يكُن هناك مجلس لقيادة الثورة المنتصرة، كما جرت العادة في الحالات المشابهة التي حصلت في غير دول.
من أبرز الأسئلة المطروحة أمام القيادة الجديدة، أو أمام مؤتمر الحوار الوطني المؤجَّل، بعدما كان مقرراً عقده في 5 كانون الثاني/ يناير 2025:
كيف سيكون شكل الدولة السورية الموعودة؟ وهل سيكون التوجُّه نحو اعتماد نظام مدني، ينشد المساواة بين السوريين في وضعياتهم الخاصة أو السياسية، ويحترم التقاليد المحلية، ويحفظ حرية الاعتقاد لدى كل المكونات الموجودة على الأراضي السورية منذ القِدم؟ وماذا عن الطروحات التي تتناول موضوع اللامركزية الإدارية الموسّعة، أو الفيديرالية؟ بينما بعض الممارسات التي تحصل اليوم – ولا سيما في بعض الجوامع والأحياء – لا تُشبِه التوصيف المدني الحرّ الذي تحدث عنه قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بل هي أقرب إلى نمطية إسلامية متشدِّدة وغير مدروسة.
وهل ستتحوَّل سوريا من اصطفاف في محور إقليمي إلى تموضُع في محور آخر؟ وماذا عن دورها العربي المُنتظر، على اعتبار أن لسوريا مكانةً مُتميِّزة في الحظيرة العربية الواسعة، وهي إحدى أهم الدول الفاعلة في جامعة الدول العربية؟
وكيف ستتعامل القيادة الجديدة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول خارجية؟ ولا سيما مع روسيا التي تحتل دور الصدارة بين أصدقاء سوريا منذ زمنٍ طويل، ولدى روسيا معاهدات موقَّعة مع سوريا حول استضافة قواعد عسكرية في طرطوس وفي حميميم على الساحل السوري، وهي ما زالت سارية المفعول، والبعض منها صالحة حتى عام 2060، في وقت يتحدث فيه البعض عن أن “قبة الباط” الروسية هي التي ساعدت في سقوط النظام.
والتحدي المهم أيضاً، هو في الخطوات التي قد تلجأ إليها القيادة الجديدة لمعالجة ملف العقوبات الدولية على سوريا، ولا سيما العقوبات التي صدرت بقوانين في الولايات المتحدة الأميركية (كقانون قيصر لعام 2020 وقانون ماغنيتسكي لعام 2012 الذي شمل سوريا أيضاً) كذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي، والقيود التي وضعتها الأمم المتحدة على التعامل مع النظام السابق، وهي تطال الأراضي السورية. والمهم في هذا السياق، كيف ستتصرَّف بعض قيادات الإدارة الانتقالية – ولا سيما رئيسها أحمد الشرع – وهؤلاء مشمولون بعقوبات شخصية سابقة أيضاً.
ما ظهر حتى الآن يُبشِّر بمستقبل واعد لسوريا، بصرف النظر عن بعض الشوائب الحاصلة. فالمواقف التي أطلقتها الإدارة الجديدة المؤقتة، تُشير إلى رغبة واضحة في تخليص سوريا بالكامل من قيودها السابقة، وهي لن تكون جزءاً من محور جديد – كما أكد أحمد الشرع شخصياً – بل ستتعامل بإيجابية مع جيران سوريا، من دون أن تكون مصدر خطر على أيٍّ منهم، وستحترم الاتفاقيات العربية، وهي تريد من أشقائها المساعدة على تجاوز الأزمات الوازنة التي يعاني منها الشعب السوري، خصوصاً الصعوبات المالية والاقتصادية. والإدارة السورية الجديدة مُرتاحة للتعاطي الإيجابي الذي حصل معها من قبل دول عربية أساسية، وهي ستبادل بالمثل هذه الإيجابيات المُهمة، كما قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني إبان زيارته لأبو ظبي.
ما يجري في بعض المناطق السورية، ولا سيما في الشمال الشرقي، يحتاج إلى عناية ديبلوماسية وأمنية مركَّزة، ذلك أن التوترات المُتنقلة في مناطق سيطرة القوى الكردية، قد تخفي سلبيات غير محسوبة، وربما تكون مدفوعة من قوىً خارجية. وبالرغم من زيارة وفد من “قسد” لدمشق، واجتماعه مع القيادة الجديدة، لم يُبدَّد ذلك المخاوف القائمة، ولواشنطن في هذا السياق دور أساسي في بلورة الوضع في تلك المناطق، ولا سيما بعد التسريبات التي تحدثت عن مُنازلات ومنازعات قد تقوم بها قوىً إقليمية مختلفة (خصوصاً إيران وتركيا) على أرضي الشمال السوري.
إن الاستراتيجية التي ستعتمدها الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع التغييرات الحاصلة في سوريا مهمة جداً، وسيكون لها أثر واسع، لكن نتائج زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركية برباره ليف الأخيرة لدمشق لم تكُن واضحة بما يكفي.
النهار العربي
————————-
الأرقام تكشف مطامع إسرائيل الكثيرة في الجولان… هل يمكن أن تستعيده سوريا؟/ محاسن عجم
السبت 18 يناير 2025
كانت مرتفعات الجولان السوري المحتل ولا تزال، ذات أهمية إستراتيجية في الشرق الأوسط، ومحور نزاعات جيو-سياسية وإقليمية لعقود من الزمن. فما هي أهميتها؟ وما هي التطورات الأخيرة التي سترسم مستقبلها؟ وهل ستقدر سوريا على استرجاع الجولان أو على الأقل جزء مما تآكل من المنطقة العازلة؟
مرتفعات الجولان
تقع مرتفعات الجولان في جنوب غرب سوريا، وهي هضبة يحدّها لبنان من الشمال، وإسرائيل من الغرب، والأردن من الجنوب، وبقية سوريا من الشرق. تمتد هذه المنطقة ذات الأهمية الجيو-سياسية على مساحة 1،800 كلم2. وكانت نقطةً محوريةً للصراع منذ احتلالها من قبل إسرائيل في عام 1967. تتميز تضاريسها بالوعورة وتشمل جبل الشيخ، أعلى نقطة في المنطقة، بينما يرتفع القسم الذي تسيطر عليه إسرائيل 2،224 متراً.
خريطة الجولان المحتل
تحتلّ إسرائيل ما يقرب من 1،200 كلم2 من مرتفعات الجولان، وفق تقارير الأمم المتحدة عن مرتفعات الجولان في 2024، وتشكل نحو ثلثي المساحة الإجمالية البالغة 1،800 كيلومتر مربع. ووفق مقولة سوريا الأسد، المساحة المتبقية والبالغة 600 كيلومتر مربع هي تحت السيطرة السورية. إلا أنّ المنطقة العازلة التي أنشئت بعد العام 1973، تمتد على الأراضي التي تسيطر عليها سوريا، لا إسرائيل، وعلى مساحة تقدّر بنحو 400 كلم2، حيث تحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح (أوندوف)، وهذا يعني أن سوريا كانت تسيطر على 200 كلم2 فقط من أراضي الجولان خارج المنطقة العازلة.
وفي عام 1981، أقرّت إسرائيل قانون ضمّ الجولان إليها، والذي لا يزال المجتمع الدولي يعارضه إلى حد كبير، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إعادته إلى سوريا. ومع ذلك، اعترفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة في عام 2019، وهي خطوة تعرضت لانتقادات واسعة النطاق على المستوى الدولي.
وخلال كانون الأول/ ديسمبر 2024، وبعد انهيار نظام الأسد، وسّعت إسرائيل سيطرتها في الجولان من خلال احتلال مناطق داخل المنطقة العازلة. وبحسب ما ورد، فقد تقدّمت القوات الإسرائيلية حتى مسافة 25 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وباتت قاب قوسين من العاصمة دمشق.
الأهمية الإستراتيجية لهضبة الجولان
يوفر موقع مرتفعات الجولان المرتفع أهميةً إستراتيجيةً بالغةً، حيث يوفّر مزايا عسكريةً وسيطرةً على موارد المنطقة كافة، وهي مهمة ومتنوعة.
الأهمية العسكرية
توفر مرتفعات الجولان ميزةً عسكريةً كبيرةً بسبب ارتفاعها الشاهق، وارتفاع جبل الشيخ، وهو أعلى نقطة في المنطقة، حيث يصل ارتفاع قمته إلى 2،814 متراً فوق مستوى سطح البحر.
وتوفر القيمة العسكرية الإستراتيجية لجبل الشيخ القدرة على المراقبة والرصد، إذ يوفر ارتفاعه العالي إطلالةً شاملةً على الأراضي المحيطة، بما في ذلك سوريا ولبنان وأجزاء من إسرائيل. وقد أنشأت إسرائيل منشآت رادار واتصالات رئيسيةً على الجبل، تلعب دوراً حاسماً في جمع المعلومات الاستخبارية.
تقسيم مساحة أراضي الجولان
بالإضافة إلى ذلك، قامت اسرائيل بتحصين تضاريس الجولان بالمواقع العسكرية المتطورة والبنية التحتية، ما يتيح لها النشر السريع للقوات والمعدّات كما يحدث الآن. واليوم باتت إسرائيل على بعد لا يتجاوز خمسةً وعشرين كلم عن دمشق من أقرب نقطة إليها في الجولان.
الموارد المائية
تُعدّ مرتفعات الجولان مصدراً مهماً للمياه بالنسبة إلى إسرائيل، حيث تساهم بنسبة 15% من إمدادات المياه في الأخيرة:
• منابع نهر الأردن: ينبع نهر الأردن من ثلاثة ينابيع رئيسية هي: نهر بانياس في مرتفعات الجولان، ونهر دان في إسرائيل، ونهر الحاصباني في لبنان. ويبلغ طول النهر 360 كيلومتراً، ويتدفق جنوباً إلى بحر الجليل ويصبّ في البحر الميت. وينقسم النهر إلى نهر الأردن العلوي (من ملتقى نهر بانياس ودان والحاصباني إلى بحر الجليل)، ونهر الأردن السفلي (من بحر الجليل إلى البحر الميت).
• بحيرة طبريا: تقع بحيرة طبريا إلى الغرب من مرتفعات الجولان، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في إسرائيل، وخزّان رئيس للمياه. تتلقى البحيرة تدفقات كبيرةً من نهر الأردن وروافده، والتي يعبر العديد منها مرتفعات الجولان. تغذّي مرتفعات الجولان نحو 15% من إجمالي إمدادات المياه في إسرائيل، وذلك في المقام الأول من خلال نهر الأردن وبحيرة طبريا. وتُستغلّ ينابيع المنطقة ومجاريها للاستخدام الزراعي والمنزلي، ما يعزز أمن إسرائيل المائي. ومنذ فقدان السيطرة على مرتفعات الجولان، أصبح وصول سوريا المباشر إلى منابع نهر الأردن محدوداً جداً.
توزيع موارد الجولان المائية
تاريخياً، كانت مياه نهر الأردن توفر نحو 25% من استهلاك إسرائيل السنوي من المياه. ومع ذلك، بسبب الجفاف وتطوير محطات تحلية المياه، انخفضت مساهمتها إلى ما يقرب من 2-13% في السنوات الأخيرة. ما بين نهر الأردن وبحيرة طبريا والآبار، يتم استخراج ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب من مياه الآبار سنوياً، ما يوفر لإسرائيل ثلث إجمالي استهلاكها من المياه. ومما لا شك فيه، أنه ستكون لاحتلال إسرائيل مناطق جديدةً داخل الجولان المحتل آثار مؤلمة على حصة سوريا من هذه المياه.
الموارد الزراعية
تشتهر مرتفعات الجولان بأرضها الزراعية الخصبة، التي تدعم زراعة المحاصيل المختلفة وتحتضن موارد معدنيةً قيّمةً. وفي ما يلي لمحة عامة عن الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج الزراعي وتوزيع الموارد بين إسرائيل وسوريا قبل التوسع الإقليمي الأخير لإسرائيل وبعده.
• التفاح: تُعدّ مرتفعات الجولان منطقةً رئيسيةً لإنتاج التفاح، حيث تنتج نحو 50 ألف طنّ سنوياً. ويمثّل هذا نحو 30% من إجمالي إنتاج التفاح في إسرائيل.
• مزارع الكروم وإنتاج النبيذ: تضم المنطقة أكثر من اثني عشر مصنعاً للنبيذ، تنتج نحو 6 ملايين زجاجة من النبيذ سنوياً. ويُعدّ مصنع نبيذ مرتفعات الجولان، الذي تأسس عام 1983، أحد أبرز منتجي النبيذ في إسرائيل.
• الزيتون وزيت الزيتون: تغطّي بساتين الزيتون أجزاء كبيرةً من الجولان، وتساهم في إنتاج إسرائيل السنوي الذي يبلغ نحو 19 ألف طن من الزيتون، تُستخدم في المقام الأول لاستخراج الزيت.
توزيع موارد الجولان الزراعية
الموارد المعدنية
إلى جانب الأهمية العسكرية والزراعية، كانت مرتفعات الجولان محوراً للتنقيب عن المعادن، خاصةً الهيدروكربونات:
• اكتشافات النفط: في عام 2015، أعلنت شركة “أفيك” للنفط والغاز، وهي شركة تابعة لشركة “جيني إنرجي”، عن اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة في جنوب مرتفعات الجولان. ولاحظ كبير الجيولوجيين يوفال بارتوف، وجود طبقة يبلغ سمكها نحو 350 متراً، وهي أكبر بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 20 و30 متراً، ما يشير إلى إمكانية وجود مليارات البراميل من النفط.
• أنشطة الاستكشاف: أجرت شركة “أفيك” للنفط والغاز، عمليات حفر استكشافية عبر مواقع متعددة، واكتشفت احتياطيات نفطية كبيرة. وقدّرت الشركة أنّ هذه الاحتياطيات يمكن أن تلبّي احتياجات استهلاك النفط المحلية في إسرائيل، والتي تبلغ نحو 270 ألف برميل يومياً.
وبما أنّ المجتمع الدولي لا يعترف حتى الآن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويعدّه أرضاً محتلةً، فإنّ هذا الوضع قد أعاق مساعي استخراج الموارد، حيث يحظر القانون الدولي استغلال الموارد في الأراضي المحتلة دون استفادة السكان المحليين. لكن بعد كانون الأول/ ديسمبر 2024، قد تتغير الأمور بسرعة ويُسمح لإسرائيل بالبدء بالاستخراج.
الموارد السياحية
يُعدّ الجولان وجهةً بارزةً للسياح، وتشير التقديرات إلى استقباله عشرات آلاف الزائرين سنوياً بما في ذلك السياح المحليين والدوليين. ولقد استثمرت إسرائيل بشكل كبير في تحسين الطرق ومراكز الزوار ومشاريع السياحة البيئية لتعزيز تجربة السياحة، التي في المقابل تولّد إيرادات كبيرةً للمنطقة، وتدعم الشركات المحلية والمطاعم ومقدمي أماكن الإقامة، وذلك بسبب مناطق الجذب التالية:
السلطات الإسرائيلية بشكل مستمر على توسيع البنية الأساسية، وبناء المصانع وتطوير فرص اقتصادية أخرى في الجولان المحتل في محاولة لجذب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة. وتقدّم الحكومة الإسرائيلية حوافز متعددةً لإنشاء وبناء المستوطنات في الجولان
جبل الشيخ: جبل الشيخ للتزلج في الشتاء، والمشي لمسافات طويلة في الصيف. ويجذب منتجع التزلج في جبل الشيخ وحده مئات الآلاف من الزوار سنوياً، ما يساهم بملايين الدولارات في الاقتصاد المحلي.
الحدائق الطبيعية: تُعدّ المنطقة موطناً للعديد من المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مثل محمية بانياس الطبيعية وجبل الشيخ، والتي تحظى بشعبية بين المتنزهين وعشاق الطبيعة.
مصانع النبيذ: تشتهر مرتفعات الجولان بمصانع النبيذ، ما يجذب عشّاق النبيذ إلى المنطقة.
المواقع التاريخية: للمواقع مثل محمية جاملا الطبيعية، أهمية تاريخية، وهي تجذب العديد من الزوار المهتمين بالآثار والتاريخ.
الديموغرافيا والاستيطان
شهدت مرتفعات الجولان تغيرات ديموغرافيةً ملحوظةً على مرّ السنين، متأثرةً بالأحداث الجيو-سياسية والسياسات الحكومية والديناميكيات الإقليمية.
قبل حرب الأيام الستة عام 1967، كان عدد سكان مرتفعات الجولان يقدر بـ130،000 إلى 145،000 نسمة، بمن في ذلك نحو 17،000 لاجئ فلسطيني. وقد أدى النزوح القسري إلى أزمة إنسانية إذ عانى النازحون السوريون لعقود في مخيمات اللاجئين أو تحت سيطرة الحكومة السورية في مناطق أقل خصوبةً وهامشيةً اقتصادياً. كما أدى إلى فقدان التراث الثقافي والقضاء على المعالم الثقافية والمساجد والمواقع التاريخية التي كانت جزءاً لا يتجزأ من الهوية السورية للمنطقة.
بعد عام 1967: بعد استيلاء إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967، فرّ جزء كبير من السكان العرب السوريين أو نزح، وبدأت إسرائيل بإنشاء المستوطنات في المنطقة.
وفقاً للتقديرات الأخيرة، يعيش حالياً في مرتفعات الجولان 53 ألف شخص، منهم 27 ألف إسرائيلي يهودي، و24 ألف درزي، و2،000 علوي.
توزيع الطوائف في مرتفعات الجولان
وفي حين ينمو عدد المستوطنين الإسرائيليين بشكل مطرد منذ سبعينيات القرن العشرين، يشهد المجتمع الدرزي استقراراً في أعداده مقارنةً بمعدل نمو المستوطنين الإسرائيليين. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تنمية بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتشجيع النمو الديموغرافي في مرتفعات الجولان، ومضاعفة عدد السكان في السنوات القادمة. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان.
نمو المستوطنات الإسرائيلية في الجولان
وتجدر الإشارة إلى عمل السلطات الإسرائيلية بشكل مستمر على توسيع البنية الأساسية، وبناء المصانع وتطوير فرص اقتصادية أخرى في الجولان المحتل في محاولة لجذب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة. وتقدّم الحكومة الإسرائيلية حوافز متعددةً لإنشاء وبناء المستوطنات في الجولان، بما في ذلك الحوافز الضريبية الخاصة، والدعم الحكومي المالي، والإيجارات المنخفضة، والتطبيق المتساهل لقوانين العمل والبيئة.
الوضع القانوني الدولي
يمثّل التوسع الإسرائيلي الأخير في المنطقة العازلة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة. إنّ مرتفعات الجولان معترف بها دولياً كأرض سورية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأي تعديلات إقليمية، خاصةً التوغلات العسكرية، تتعارض مع اتفاقية فكّ الارتباط لعام 1974، ومبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 497، الذي أعلن ضمّ إسرائيل مرتفعات الجولان في عام 1981، باطلاً ولاغياً.
بعد كانون الأول/ ديسمبر 2024، صمتت دول الغرب عن احتلال إسرائيل أراضي جديدةً، ما يشجع على استمرار تصرفاتها العدوانية. تنظر اليوم سوريا إلى صمت الجهات الفاعلة العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي، أو ردود أفعالها المحدودة، على أنه فشل في دعم القانون الدولي، ما يشجع إسرائيل أكثر فأكثر بعد، ويؤدي إلى تآكل الثقة بقدرة المجتمع الدولي على التوسط في الصراع بشكل عادل.
لماذا قد يضيع ما تبقّى من الجولان؟
هنالك احتمال كبير لأن يضيع ما تبقى من الجولان، وأسباب هذا الاحتمال كثيرة: أولاً، لأنّ التوسع الذي قامت به القوات الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2024، في المنطقة العازلة، سيؤدي إلى تغيير كبير في الديناميكيات الديموغرافية في مرتفعات الجولان، من ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين الى التخطيط لبناء مستوطنات جديدة لمضاعفة عدد السكان المتوقع. وتهدف مثل هذه التحولات الديموغرافية إلى ترسيخ سيطرة إسرائيل على المنطقة، وتعقيد أي مفاوضات مستقبلية بشأن استعادتها.
وقد زاد من تعقيدات الوضع موقف بعض وجهاء الدروز الذين طالبوا بالانضمام الى إسرائيل، خشيةً مما ينتظرهم في سوريا ما بعد الأسد، وقد سارع زعيم الدروز في لبنان (وليد جنبلاط)، إلى سوريا في محاولة لضبط الوضع هناك، والتأكيد على هوية الجولان العربية. وقد تستخدم إسرائيل قضية “حماية الدروز” لضمان احتلالها أو أقلّه إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في ما تبقّى من مناطقهم.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح السيطرة الإسرائيلية على أعلى موقع في جبل الشيخ، إسرائيل أفضليةً إستراتيجيةً كبرى، كذلك الأمر بالنسبة إلى السيطرة على مصادر المياه الرئيسية واحتياطيات النفط المحتملة في المنطقة العازلة. توفر هذه العوامل لإسرائيل موطئ قدم اقتصادياً وإستراتيجياً أقوى، ما يعزز نفوذها في النزاعات الإقليمية.
وتبقى التصريحات الإسرائيلية الفجة هي الأخطر، إذ سبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، “أنّ إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه سوريا”، وقال: “الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام”. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكد نتنياهو أنّ “الجولان سيكون جزءاً من إسرائيل إلى الأبد”.
على ضوء كل هذه المعطيات، وبعد أن قامت إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بتدمير معظم قدرات الجيش السوري في أنحاء سوريا كافة، سيكون من الصعب على سوريا استرجاع أراضي الجولان والعمل على نهضتها تحت السيادة السورية، بعد أن ضاقت سبل وقف هذا الاحتلال الغاشم. فهل من يبحث عن حلّ عادل، أو قُضي الأمر وانتهى؟
رصيف 22
————————-
القصة بدأت من القامشلي… كيف صنع فرحان بلبل بصمته في تاريخ المسرح السوري؟/ لمى طيارة
السبت 18 يناير 2025
في عام 2022، أتاحت لي الظروف لقاءَ الفنان والكاتب والشاعر والمخرج السوري فرحان بلبل، ابن مدينة حمص. كانت زيارة مطولة في منزله أو لنقُل في الغرفة التي اختارها في منزله منذ عام 1973، لتكون مكاناً لنشاطه الثقافي، حيث امتلأت تلك الغرفة بمعظم صور عروض فرقته (فرقة المسرح العمالي) بالإضافة إلى بعض الأوسمة والشهادات. وكانت هذه الغرفة مكاناً ثقافياً تقام فيه الندوات في معظم الأوقات، بالإضافة لكونها مكاناً لإقامة الأصدقاء القادمين من داخل سوريا أو خارجها، كما أخبرني حينها.
استقبلني بدوري في نفس الغرفة برفقة ابنته عفراء التي كانت حاضرة في معظم الحوار، لتؤيد ما يقول أو لتؤكد معلومةً خانته ذاكرته حولها. كان سعيداً جداً بهذا الحوار، كما أخبرني، وليس فقط كما شعرت. وكان يريد أن يحكي من خلاله عن جل تجربته، لا أن يكون مجرد لقاء سريع وخاطف عنه. فاستجبت لذلك وكأننا عقدنا اتفاقاً ضمنياً في ما بيننا؛ فحدثني عن طفولته المبكرة التي صنعت منه خطيباً لدى عائلته التي كانت تقيم حلقات للذكر أو ما يسمى “احتفالات صوفية”، وكيف تم تلقيبه بفارس المنابر حتى قبل بلوغه 15 عاماً. كما أخبرني عن عمه الذي شجعه على ذلك بشكل كبير حين اصطحبه إلى أحد التجمعات ليلقي خطبة، وصاروا ينادونه منذ ذلك الوقت بالفتى فرحان بلبل.
لا أعرف كيف انكبت على ذاكرتي اليوم كل تلك التفاصيل؛ ربما لأن رحيل بلبل (1937-2025) جاء على رأسي كالضربة، رغم أنني كنت أجهز نفسي لهذا الخبر منذ أيام؛ فابنته عفراء كانت شبه متأكدة أنه راحل هذه المرة لا محالة، وسألت نفسي: هل من المعقول أن يكون قلبه قد تعب وهو بانتظار وصول ابنه نوار بلبل الغائب قسراً عن سوريا؟ لكن المفرح، بكل تأكيد، أنه استطاع اللقاء به وتقبيله ولمسه وربما توديعه. ربما كان متعباً وكان يمسك قواه وقلبه فقط لكي يلتقي ابنه ويودعه.
لم يحظ بلبل بفرصة لتعلم فن المسرح بشكل أكاديمي، لكنه على الرغم من ذلك، تعلمه من الكتب التي قرأها ومن التجارب الكثيرة جداً التي حضرها في مسارح سوريا. كما أخبرني قائلاً: “كنت أذهب لمشاهدة العروض المسرحية في أي مكان تعرض فيه داخل سوريا، مهما كان بعيداً. سافرت إلى دير الزور وحلب واللاذقية ودمشق، أشاهد العرض وأعود أدراجي لمدينتي حمص، وكانت أقرب العروض بالنسبة لي عروض مدينة دمشق على اعتبارها المدينة الأقرب لمدينة حمص، وبالتالي كونت في تلك المرحلة صورة شبه متكاملة عن المسرح السوري”.
كما أخبرني عن أول نص كُلّف بكتابته صدفةً في العام 1960 حين كان مدرساً في مدينة القامشلي، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وفي هذه المدينة النائية حدثت المفارقة، وبدأت علاقته مع المسرح عندما طلب منه إسكندر عزيز أن يكتب مسرحية ليقوم بإخراجها. فكتب نصاً بعنوان “الثأر الموروث”، عن أسرة فلسطينية تهاجر من فلسطين بعد النكبة حاملةً ذكرياتها وآلامها التي تحولت إلى ثأر شخصي ووطني موروث عند أبنائها. كانت فلسطين جرحاً أطل في أول مغامرة مسرحية لبلبل، وظلت حاضرة في أكثر ما كتب في ما بعد.
لكن توقفه عند مرحلة “المسرح العمالي” التي استمرت لحوالي 40 عاماً، كانت أهم ما أراد المرور عليه، وخاصة أن الفرقة أسست في مدينة حمص المعروفة أنها من أكثر المدن محافظةً، وكيف أنه بدا أباً متفتحاً وديمقراطياً لدرجة أنه سمح لبناته بالانضمام لفرقته المسرحية، في حين كان يرى البعض وقتها، حتى في موضوع الانتساب دراسياً للمعهد العالي للفنون المسرحية، أمراً غير لائق لبناتهم.
عند هذه النقطة تدخلت عفراء قائلة: “تربينا ضمن فرقة المسرح العمالي وكنا نشعر بالأمان وجوّ العائلة ضمن الفرقة، التي تتكون من أقرباء (أخ وأخته)، يذهبان ويعودان برفقة بعضهما بعضاً؛ فالبروفات كانت تستمر لساعات وكنا نسافر سوياً. بالتالي كان لدينا جو عائلي. اما بالنسبة لأعضاء الفرقة، فقد مرّ عليها كثيرون، بعضهم استمرّ لساعات وبعضهم لأيام، وبعضهم لشهور، والبعض الآخر استمر منذ التأسيس وحتى آخر العروض. كنا نشرح لهم عن المسرح وعن أهميته وأنه مكان ليس للتسلية، وعن المهام المناطة بالمنتسب للفرقة والتي تتجاوز التمثيل للديكور وتنظيف المسرح. لذلك من كانت نواياه سيئة انسحب فوراً”.
أما بلبل فرد: “كنت رأس حربة في التغيير الاجتماعي والتغيير في عقلية أهل مدينة حمص؛ رجل أدخل بناته للعمل في المسرح كان أمراً كبيراً جداً، وخاصة أنني أنتمي لأسرة ‘كريمة’، الأمر الذي بثّ الجرأة لدى الأسَر الكريمة الأخرى لإرسال بناتها للمسرح، أسوة بما فعل فرحان بلبل”.
في جعبة بلبل، خريج كلية الآداب من قسم اللغة العربية، 37 نصاً مسرحياً تمت طباعتها ونشرها جميعها، من ضمنها ثلاثة نصوص مسرحية للأطفال، بالإضافة إلى 15 كتاباً في النقد المسرحي. أما آخر كتاب له والذي صدر لأربع طبعات متتالية في مختلف الدول العربية فكان “أصول الإلقاء والإلقاء المسرحي”، وهو الكتاب الذي ألفه بعد تجربة طويلة في تدريس مادة الإلقاء لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. كما أنه أخرج عشرات المسرحيات، سواءً تلك التي كتبها بنفسه أو لكتاب آخرين، وكان سعيداً جداً بتلك التجارب وبتشجيع الجمهور له.
أخبرني عن عروضه التي أقامها سواءً في سوريا أم خارجها، وكيف كانت تنتهي بالتصفيق وقوفاً، وكانت عيناه تلمعان حين مرّ على العرض الذي قدمه في بغداد: “القرى تصعد إلى القمر عن نص دائرة الطباشير”، وخاصة العروض الأخيرة التي أمطرت بغداد فيها مطراً كثيفاً، قائلاً: “المعروف أنه لا مجارير في بغداد، مما يعني أنها ربما ستغرق. فاقترحوا علينا عدم الذهاب للمسرح، لأنه ما من جمهور يمكنه الوصول. لكنني أصررتُ على الحضور، وعندما وصلنا وجدنا المسرح الذي يضم 650 مقعداً ممتلئاً، والوقوف أكثر من الجلوس”.
لكن بلبل كان حزيناً أيضاً في ذلك اللقاء على واقع المسرح الذي لا أهمية له، قائلاً: “وكأن المسرح أصبح مجرد ‘كمالة عدد، لا أكثر’ ،فأحياناً نشاهد عروضاً مسرحية تافهة أو ضعيفة كنوع من الواجب “.
اليوم برحيل فرحان بلبل تفقد سوريا والمسرح السوري قامة كبيرة من قامات المسرح السوري، كان لها بصمة وتأثير كبير على جيل كامل، سواءً من خريجي المعهد أم من العاملين في فرقته، “فرقة المسرح العمالي”.
رصيف 22
———————————-
=======================