سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 08 شباط 2025
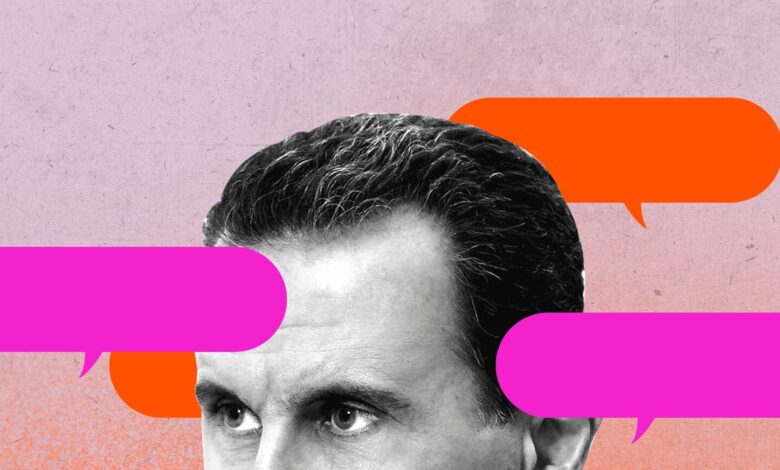
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————
إنه فريد المذهان… “قيصر” سوريا/ مناهل السهوي
08.02.2025
كل ما احتاجه فريد المذهان “قيصر” كان ربطة خبز وجواربه وشجاعة منقطعة النظير، ليخفي واحداً من أهم الأدلة على وحشية نظام الأسد، قيصر لم يكن بطلاً بأسلحة متطورة، بل رجل ذو حسّ إنساني جعل منه شاهداً على جريمة كادت أن تبقى بلا دليل.
ظلَّ “قيصر” لسنوات بالنسبة للسوريين أشبه بأسطورة أو رمز يتجاوز حدود الواقع، لكنه في جوهره كان بطلاً من لحم ودم، بطلاً يشبههم وينتمي إلى عالمهم. لم يكن قيصر شخصية خارقة أو رجلاً مجهول الهوية من روايات الأبطال، بل كان موظفاً عادياً، شخصاً يمكن أن تصادفه يومياً في شارعك أو مكتبك، لكنه امتلك شجاعة استثنائية جعلته يغيّر مجرى التاريخ السوري.
من هو قيصر؟
أصبح بالإمكان الإجابة عن سؤال من هو “قيصر”؟، إنه المساعد أول فريد ندى المذهان، من بلدة الشيخ مسكين في درعا وكان يعمل في دمشق. قبل الثورة كان مسؤولاً عن تصوير الحوادث المرورية، وبعدها نقله النظام لتصوير جثث المعتقلين.
جاء فريد من بلدة تشبه البلدات والأحياء التي ينحدر منها السوريون، لولا هذا لما اتصل بي صديقي، وقال لي: “لك طلعت بعرفه، طلع من عنا”.
نشأ فريد وسط معاناة مألوفة، لكنه قرر أن يتحمّل مسؤولية كشف الحقيقة وبقراره هذا، أثبت قيصر أن البطولة ليست حكراً على شخصيات عظيمة أو قوى خارقة، بل هي خيار شخصي يتّخذه إنسان عادي في لحظة مفصلية. الأبطال في النهاية هم أبناء عائلاتنا، جيراننا، أصدقاؤنا، أولئك الذين يملكون الشجاعة ليقفوا في وجه الظلم.
عندما نُشرت الصور التي سرّبها “قيصر”، شكّلت واحدة من أكثر الأرشيفات الديكتاتورية دموية في العصر الحديث، وعلى الرغم من أن العالم كان يدرك مسبقاً وحشية نظام الأسد، إلا أن هذه الصور جاءت كدليل بصري قاطع، لا يمكن إنكاره أو تجاهله، على حجم الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلين، لقد كانت هذه التسريبات بمثابة صدمة تاريخية، إذ كشفت للمرة الأولى وبشكل موثّق، عن التعذيب المنهجي والموت الجماعي في أقبية المعتقلات السورية.
تفاعل العالم مع الصور بشكل واسع، حيث تناولتها أكثر من 1000 وسيلة إعلامية حول العالم، وأثارت نقاشات حادة في الأوساط الحقوقية والسياسية. بعد نشر صور قيصر، لم تعد مسألة التطبيع مع الأسد مجرد خيار سياسي خلافي، بل تحوّلت إلى معضلة أخلاقية أمام الحكومات التي كانت تفكر في إعادة العلاقات معه. يمكن القول إن هذه الصور أسست لحاجز غير مرئي بين النظام السوري والمجتمع الدولي، إذ أصبح التورّط في إعادة تأهيله سياسياً، أشبه بمحاولة تبرير ما لا يُبرَّر.
الحقيقة في ربطة خبز وجورب
وبرغم أن اسم قيصر استخدمه الأباطرة الرومان بعد يوليوس قيصر، الذي كان قائداً عسكرياً وسياسياً بارزاً، وبات يُستخدم اليوم للإشارة إلى القوة والعظَمَة، ويرتبط بالحكم والقيادة. لكن في حالة “قيصر” السوري، أصبح الاسم رمزاً للشجاعة والعدالة بدلاً من السلطة، وهنا تمكّن فريد عن غير قصد وبحدسه الإنساني وطموحه، بتحقيق العدل، من منح اسم يرتبط بالقيادة والقوة إلى اسم يحمل قيمة إنسانية وأخلاقية.
لم نمتلك يوماً صورةً لقيصر. ربما تخيلناه كرجل يشبه أبطال الأفلام البوليسية، أولئك الذين يمتلكون تقنيات متطورة وأدوات تجسس حديثة، ينتقلون بسيارات فاخرة ويتواصلون عبر قنوات سرية لا تخترقها الرقابة. لكن قيصر لم يحتج إلى كل ذلك، كانت أدواته شديدة البساطة، كل ما احتاجه كان ربطة خبز وجواربه، ليخفي واحداً من أهم الأرشيفات السورية. قيصر لم يكن بطلاً بأسلحة متطورة، بل بوعي إنساني جعل منه شاهداً على جريمة كان يمكن أن تبقى بلا دليل.
استخدم فريد شيئين بسيطين لإخفاء أدلته: الجوارب وربطة الخبز، اللذين يمتلكان في الذاكرة السورية مكانة حياتية وحميمة. الخبز، الذي رافق السوريين على الحواجز وأمام الأفران، حيث انتظروا لساعات طويلة للحصول على لقمة تسد جوعهم، تحوّل في هذه القصة إلى وسيلة للخلاص، ليس من الجوع هذه المرة، بل من طمس الحقيقة. أما الجوارب، التي لطالما بيعت على الأرصفة وصعد باعة متجولون إلى الحافلات ليعرضوها بأسعار زهيدة، فقد أصبحت بشكل غير متوقّع حافظة لأحد أهم الأرشيفات السورية.
إن ارتباط إخفاء هذا الأرشيف بشيئين يعكسان عوز السوريين وحاجاتهم اليومية ليس مجرد تفصيل عابر، بل هو دلالة قاسية على طبيعة الظرف الذي وُثّقت فيه هذه الجرائم. في ظل الاستبداد، يصبح حتى الخلاص مرهوناً بأدوات الفقر، وكأن السوري، حتى في لحظات مقاومته، لا يجد سوى ما اعتاد حمله في يومياته الثقيلة، ليكون وسيلته في مواجهة الموت والنسيان.
لم يقتصر دور فريد على تهريب الصور، بل سعى أيضاً إلى مساعدة عائلات المخفيين والمعتقلين، محاولاً إيقاف استنزافهم المالي على يد عناصر النظام الذين ابتزّوهم بوعود كاذبة عن مصير أحبّائهم. في مقابلته مع قناة الجزيرة، قال بحسرة: “أنا ما قدرت أتمالك نفسي، عبيقتلوا أولادنا، قهرونا وذلّونا، وبرجعوا بياخدوا منا مصاري ورشاوي مشان يفرجونا أولادنا ميتين!”.
لم يكن تهريب الصور سوى البداية، إذ ظلّ فريد يواجه الألم يومياً وهو يقلّبها واحدة تلو الأخرى. كانت الوجوه الممزقة بالكدمات والحروق تروي قصصها له بصمت: “عندما كنت أشاهد الصور، أشعر أنها تحدّثني” يقول فريد، الذي لم يتمكّن حتى من التعرّف على أقاربه بين الضحايا، بعدما طمست آثار التعذيب ملامحهم المألوفة.
نظام الأسد من جوّع السوريين وليس قيصر
يوجّه البعض أصابع الاتهام إلى قيصر، معتبرين أنه السبب في تجويع السوريين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. لا شك في أن العقوبات الأحادية لطالما كانت سلاحاً غير عادل يدفع ثمنه المدنيون قبل الأنظمة، ولكن قبل إقرار القانون، كان الاقتصاد السوري منهاراً أصلاً بسبب الفساد، وسوء الإدارة، وتمويل النظام لحربه بدل دعم الاقتصاد، كما كانت القطاعات الإنتاجية مدمّرة والأسعار مرتفعة، بينما استخدم النظام سياسة التجويع سلاحاً في المناطق المحاصرة، كما فعل في الغوطة.
إذا كان التجويع اليوم يُستخدم لإدانة قيصر، فلماذا لم يُدن الأسد حين مارس التجويع الممنهج بحق المعتقلين والمدنيين؟ كيف يصبح قانون أُقرّ بعد اختفاء أكثر من 120 ألف شخص هو المشكلة الأخلاقية الوحيدة؟ هذا التناول الانتقائي يعكس توظيفاً مزدوجاً للمعايير، إما عن جهل بحقيقة ما حدث وإما عن تواطؤ متعمّد.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار أن قانون قيصر تمكّن من نخر النظام من الداخل، محوّلاً إياه إلى كيان هشّ، غير قادر على المواجهة أو الصمود بالقوة نفسها التي امتلكها سابقاً، لطالما آلمت العقوبات الأنظمة التي تعتمد على التمويل العسكري والقمعي للبقاء.
لكن المسألة ليست تمجيداً للعقوبات الأميركية، بل تأكيد أن العدل لا يكون انتقائياً. حين يصبح كاشف الحقيقة هو المتّهم، وتُبرَّر مأساة بينما تُدان أخرى، فنحن أمام خلل أخلاقي لا يمكن تجاهله.
اليوم، بدلاً من القول “أعطِ ما لقيصر لقيصر”، يمكن القول إن قيصر قدّم لنا كل ما يملك، إذ خسر حقه في حياة طبيعية، بعدما فُرضت عليه تدابير أمنية صارمة لحمايته، كما كشف في مقابلته مع قناة “الجزيرة”.
حُرم من الاندماج في المجتمع الفرنسي، من تعلّم اللغة، ومن العمل، وعاش هو وعائلته في الخفاء، تكريماً لأرواح المعذبين والمختفين، لكل الوجوه التي ظهرت في صوره المهربة، ولم يستطع أحد التعرف على أصحابها، لأن النظام السابق لم يترك ملامح على الوجوه ولا لحماً على العظام.
درج
———————————–
تحصين سورية عربياً/ بشير البكر
08 فبراير 2025
سورية منهكة، تحتاج كثيراً من الدعم والمساعدة والعمل، فالتركة الأسدية ثقيلة جدّاً، ولا تقتصر على أضرار الحرب التي شنّها النظام ضدّ الشعب منذ عام 2011، وأدّت إلى دمار واسع في المحافظات كلّها، شمل العمران والبنى التحتية والمصادر، التي كانت عماد الاقتصاد في الزراعة والنفط. وعدا ذلك، فهي مستهدفة أمنياً وسياسياً من أطراف خارجية، تأتي على رأسها إسرائيل، التي أغضبها سقوط نظام بشّار الأسد، ولذلك أوقفت العمل باتفاقية فصل القوات، ودمّرت القدرات العسكرية الخاصّة بالجيش السوري، واحتلت مساحات من أراضي سورية، وشيّدت تحصينات في المواقع الاستراتيجية، وباتت تهدّد أمن العاصمة، وتضعها في مرمى النيران. وتشكّل إيران مصدر التهديد الثاني. وهذا ما تعكسه ردّات الفعل الرسمية، التي لا تزال تتوالى من طهران بعد فرار الأسد، وكلّها تهدّد وتتوعّد بتقويض الحكم الجديد، وهذا دليل على أن إيران ليست في وارد التسليم بالخسارة الاستراتيجية التي تلقّتها.
تحصين سورية مصلحة عربية، لأن عودة هذا البلد إلى العالم العربي تعزّز الموقف العربي المشترك، وتقطع الطريق على محاولات التدخّل الأجنبية في الشؤون العربية. وقد برز منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد أن هناك إدراكاً من قبل دول الخليج العربي والأردن لهذه المسألة، وعكست ذلك زيارات التهنئة إلى دمشق بالعهد الجديد، من قطر والأردن والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. وخطت السعودية والأردن وقطر خطوات عملية في هذا الطريق، وكان لاجتماع الرياض العربي الدولي في الـ12 من الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني) أهمية كبيرة ضمن مساعي رفع العقوبات الدولية عن سورية، فحضره ممثّل رفيع للولايات المتحدة، وعدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية، ومسؤولة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.
خطوتان عربيتان مهمّتان في هذا الطريق، حصلتا خلال الأيام القليلة الماضية. الأولى تمثّلت بأرفع زيارة لمسؤول عربي ودولي، تلك التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق في يوم 30 من الشهر الماضي، وعكست التزام هذا البلد، الذي شكّل سنداً كبيراً للثورة السورية، وداعماً للسوريين طوال أعوام التهجير. وعلى قدر الرهان على انتصار الثورة السورية، يأتي تعهّد قطر اليوم بتقديم أشكال الدعم كلّها من أجل إعادة إعمار سورية، ومواكبة تجربتها الجديدة حتى تستقرّ، وتسير في درب التعافي السريع. والخطوة الثانية الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، التي تحمل بُعداً رمزياً مهمّاً، يرقى إلى إعلان سياسي سوري حول المرحلة المُقبلة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بما تحمله من توجّه إلى إحياء التضامن العربي بصورته التقليدية، الذي تشكّل فيه العلاقات السورية السعودية المصرية رافعة العمل العربي المشترك، ومرجعية رسم السياسات العربية العامّة، وتحديد الموقف من قضايا العرب الأساسية. وعلى هذا، فإنها توجّه رسالةً إقليميةً صريحةً لإيران التي استهدفت تقويض الأمن العربي، من خلال استغلال فراغ الدور العربي في العقود الماضية، وتوغّلت في عدّة بلدان عربية؛ سورية ولبنان والعراق واليمن، وهدّدت في العقدين الماضيين دولاً في مجلس التعاون الخليجي، منها السعودية، من طريق مليشيات الحوثيين في اليمن، الذين شنّوا هجمات في الأراضي والمنشآت الحيوية السعودية. وقد سبق للشرع بعد أيام من وصوله دمشق، أن تحدّث بصراحة عن أن التحوّل الجديد في سورية وضع حدّاً للتدخّلات الإيرانية في المنطقة، وهذا يلتقي مع توجّهات السعودية، وعدد من بلدان الخليج العربي، التي بقيت تنظر بقلق كبير إلى هذا الدور بسبب مشاريع إيران التوسّعية في العالم العربي، ومحاولاتها إثارة النزعات الطائفية بما يخدم مصالحها في الهيمنة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
العربي الجديد
——————————-
ملامح الاحتضان العربي الخليجي لسوريا الجديدة/ عمر كوش
8/2/2025
صل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير لدى وصوله مطار دمشق الدولي، أخوه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته دمشق وفي استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع (الصحافة القطرية)
بدأت تتضح شيئًا فشيئًا ملامح الوجهة التي سيتخذها نظام الحكم الجديد في سوريا، وتوجهاته السياسية الداخلية والخارجية، حيث يركز داخليًا على تنفيذ خُطة انتقال سياسي خلال المرحلة الانتقالية، تتكون من ثلاث نقاط:
أولها، تشكيل حكومة تكنوقراط موسّعة.
وثانيها، اختيار هيئة أو مجلس تشريعي مؤقت.
وثالثها، عقد مؤتمر حوار وطني ينتج عنه إعلان دستوري، وصولًا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويفترض أن يتم ذلك بالتزامن مع العمل على أولويات توفير الأمن والاستقرار، وتأمين الحاجيات المعيشية للسوريين، والعمل على التعافي الاقتصادي، وإعادة إعمار ما دمّره نظام الأسد.
أمّا خارجيًا، فإن عنوان توجّه الإدارة الجديدة، هو تطبيع علاقاتها مع دول الجوار والإقليم والعالم، حيث أرسلت رسائل طمأنة عديدة إليها، تفيد بأن سوريا ستسعى إلى أن تكون عامل استقرار في المنطقة، وأنها ليست تهدف إلى تصدير الثورة، بل اعتبرت أن الثورة انتهت بسقوط النظام، وبدأت مرحلة الانتقال إلى بناء الدولة، التي تريد العيش في سلام مع دول محيطها العربي والإقليمي والعالم.
التوجه العربي
حددت الإدارة الجديدة في سوريا سياستها الخارجية بأولوية وصل ما قام نظام الأسد البائد بقطعه من روابط تاريخية وثقافية وسياسية بين الشعب السوري وحاضنته العربية. وشكّل التوجه نحو المنظومة العربية، المحدد الأساسي في السياسة الخارجية لسوريا الجديدة. ليس فقط من أجل مساعدتها في الخروج من الأوضاع الكارثيَّة التي خلفها نظام الأسد البائد، وإعادة إعمار ما دمره هذا النظام، بل لأنها ترى أن موقع سوريا الطبيعي هو بين دول المنظومة العربية.
وبالتالي لم تكن مصادفة أن أول زيارة خارجية، قام بها وفد مكون من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، كانت وجهتها الرياض، ثم الدوحة، وأبوظبي، وكذلك كانت الزيارة الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، بوصفها أول زيارة خارجية له، والذي استقبل بحفاوة كبيرة من طرف المسؤولين في المملكة، وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ولعل التوجه العربي لسوريا الجديدة يدحض الأقاويل حول ارتمائها في الحضن التركي، وأنها استبدلت النفوذ الإيراني بالنفوذ التركي، وذلك على الرغم من سعيها إلى بناء علاقات قوية وإستراتيجية مع جارها التركي، الذي ساعد الشعب السوري في محنته خلال الحرب التي كان يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي والإيراني ضد الشعب السوري على مدى أكثر من ثلاثة عشر عامًا.
تكمن خلفية التوجه العربي في كونه مسعى تجسده رغبة حكام سوريا الجدد في عودة بلادهم إلى موقعها الطبيعي ضمن المنظومة العربية، بما يعني إنهاء سياسة المحاور والمعسكرات التي كان يتبعها نظام الأسد البائد، وأسفرت عن وقوع سوريا في قبضة مشروع النظام الإيراني التوسعي في المنطقة، الذي استخدمها ساحة في صراعاته، فضلًا عن تغلغل هذا النظام في مختلف مفاصل الدولة السورية.
كما أنها أفضت أيضًا إلى تحوّل سوريا لقاعدة عسكرية متقدمة للنظام الروسي في منطقة الشرق الأوسط، واعتبارها نافذة إستراتيجية يطل بها على مياه البحر الأبيض المتوسط، ونقطة انطلاق لتقوية نفوذه في المنطقة.
الاحتضان العربي
قُوبل التوجه العربي للنظام الجديد في سوريا باحتضان عربي غير مشروط، أي بعكس التواصل الغربي الذي ربط اعترافه وقبوله بالتغيير الحاصل بالخطوات التي سيتخذها الحكم الجديد، حيث وضع مسؤولون غربيون عددًا من الشروط تمسّ طريقة التعامل مع مكونات المجتمع السوري وتمثيلها في هيئات الحكم، وحقوق المرأة ومحاربة الإرهاب وسواها.
أما في الجانب العربي، فإنه منذ الأيام الأولى لإسقاط نظام الأسد، سارعت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى التعبير عن ترحيبهما واهتمامهما بالتغير الحاصل، فأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أعربت فيه عن ارتياحها “للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها”.
وبدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية على “متابعة الدوحة باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا”. أما رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، فقد تحدث عبر الهاتف مع الرئيس أحمد الشرع.
وأرسلت كل من قطر، والسعودية، والأردن، والبحرين، والكويت، وليبيا وفودًا رفيعة المستوى إلى دمشق، لكن بالمقابل، أحجمت دول عربية أخرى عن التواصل مع الإدارة الجديدة، واختارت موقفًا سلبيًا حيال التغيير الحاصل في سوريا، بل ووضع بعضها شروطًا تحاكي الشروط الغربية.
مثّلت دول الخليج العربي رافعة الاحتضان العربي للتغيير الحاصل في سوريا، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من أن النموذج السوري في التغيير حمل الإسلاميين إلى السلطة فيها، حيث سارعت دولة قطر إلى الاعتراف بهذا التغيير، وإعلان الوقوف إلى جانب الإدارة الجديدة ومساعدتها على كافة المستويات، واتسق ذلك مع مواقفها الداعمة للشعب السوري، التي لم تتغير منذ قيام الثورة السورية في منتصف مارس/ آذار 2011.
لم تتأخر المملكة العربية السعودية كذلك في تأييده، فأبدت استعدادها للوقوف إلى جانب سوريا، ومساعدتها من أجل التعافي المبكر، ودعمها من أجل رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية المفروضة عليها؛ بسبب ممارسات نظام الأسد البائد، وكذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة، وذلك رغم موقف كلا البلدين الرافض لأطروحات وأيديولوجيات حركات الإسلام السياسي في المنطقة.
ويمكن القول إن دول الخليج العربي اعتبرت أن التغيير الذي حدث في سوريا عالج مشكلة كبيرة كانت مصدر إزعاج لها، فقد وجه ضربة قوية للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. إذ كانت سوريا خلال عهد النظام البائد حلقة ربط هامة للممر الواصل من طهران مرورًا ببغداد وصولًا إلى بيروت. وقد خسر النظام الإيراني الساحة السورية بوصفها من أهم مناطق النفوذ التي كان يستخدمها في المنطقة لتنفيذ مشروعه القومي التوسعي.
ولا تريد دول الخليج أن تترك سوريا وحدها فتسعى إيران مجددًا إلى ملء الفراغ فيها مثلما فعلت في العراق قبل أكثر من عشرين عامًا. ولا شك في أن احتضانها للنظام الجديد في سوريا سيقوي ابتعاده عن النظام الإيراني، ويجعل اعتماده على المنظومة العربية خيارًا إستراتيجيًا، وهو ما عبر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. وقد توّج الاحتضان العربي بزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، في اليوم التالي لاختيار أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية.
تعي دول الخليج أن سوريا تشكل دولة أساسية في التحولات الجيوستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا، وهو ما تطلب انخراطها في التحول الحاصل في خرائط النفوذ وموازين القوى الجديدة في المنطقة، من أجل حماية مصالحها في منطقة تعجّ بالصراعات وعدم الاستقرار.
وهنا تأتي أهمية بناء منظومة تعاون مع سوريا الجديدة، وضرورة دعمها للتعافي، وتذليل التحديات والعقبات الكثيرة التي تواجهها في المرحلة الانتقالية، وألا يختصر دورها في الدعم الإنساني والاقتصادي، بل أن يتجاوزه إلى الدعم السياسي، وخاصة العمل من أجل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث سوري
الجزيرة
————————————————-
معنى المعارضة في سورية الجديدة/ مضر رياض الدبس
08 فبراير 2025
وصلَ مفهومُ المعارضة إلى سورية المنتصرة مُنهكاً، يحتاج إلى استرخاءٍ دلالي وإعادة فهم. بل يمكن القول إن هذا المفهومَ بالمعنى الذي عرفناه في السنوات الأربع عشرة الماضية انتهى. ولأنه مفهومٌ مهمٌّ ولا يمكن الاستغناء عنه أبداً، ينبغي أن نُفكِّر في إعادة بنائه بصورةٍ حديثة، كما نُفكِّر في بناء المؤسّسات والدستور. ونتناول هذه الفكرة في جُزأين. الأول في معنى المعارضة الذي كان في زمان النظام البائد، والثاني في معنى المعارضة في المرحلة الانتقالية، ومن ثمّ في سورية الجديدة.
كانت المعارضة في فترة حكم حافظ الأسد كلمةً مخيفةً، وتحديداً بعد أن مكّن قبضته في النصف الأول من ثمانينيّات القرن الماضي؛ وكانت عملاً يتطلّب شجاعةً كبيرةً واستعداداً للتضحية، من ثمّ كانت موقفاً أخلاقياً في جذره. وكثيرٌ من المعارضين لم يكونوا سياسيين متمرّسين بطبيعة الحال، فالنظام لم يشارك معارضيه السياسة، وطرائق الوصول إلى المعلومات، واحتكر ذلك دائماً. لذلك ظلَّ الرفض الأخلاقي لممارسات الأسد الإجرامية المُحدِّد الرئيس لمعنى المعارضة، أو ربّما نقول: المعارضون هم الشجعان الأخلاقيون، ومعظمهم كانوا مؤدلجين، تبنّوا أيديولوجيات ذات جذور إسلامية، أو يسارية، في الأغلب. مع قدوم الابن، في عام 2000، لم تتغيّر المعادلة كثيراً، وظلّت صفتا الشجاعة والأخلاق ملازمتَين لمعنى المعارضة بالعموم، وتحديداً مع قمع “ربيع دمشق”، والعودة إلى القبضة الأمنية الشديدة بعد عام 2005. وكانت علاقة مفهوم المعارضة بالمجتمع علاقة ضعيفة دائماً، ولم تتمكّن المعارضة من حشد شعبي (إلا نادراً)، بل كانت المعارضة بوصفها نخبةً سياسيةً تشعر بخذلان المجتمع.
وفي المجمل، ظلَّ معنى المعارضة يوجد في عتبة السياسة، وهي عتبة كانت محظورةً بطبيعة الحال، حتى إن عائلات المعارضين وأصدقاءهم ومُحبيهم والخيِّرين الذين يريدون لهم الخير (يعني غالبية السوريين) صاروا يتصرّفون وكأنهم حرَّاس لهذه العتبة أيضاً، يمنعون أبناءهم من دخولها، لا لأنهم لا يحبّون أن يدخلوها، ولكن خوفاً عليهم من البطش والسجن والموت. وبمرور الوقت، تَأقلَمَ السوريون مع الربط الوثيق بين حزمة الشجاعة والأخلاق وحُبّ الوطن، وحزمة مصطلحات محاكم أمن الدولة مثل “وهن نفسية الأمة” أو “النيل من هيبة الدولة” أو “عداء أهداف الثورة”، وإلى ما هنالك. وليكون المرء أكثر إنصافاً، لا بدّ من القول إن لهذه المعارضة خصوصية، فهي لم تكن معارضةً حقيقةً لنظام سياسي، بل كانت معارضةً لعصابة لها امتداد إقليمي، وعلاقات دولية، اختطفت الدولة السورية، وسيطرت على مقدراتها بالشرّ والهمجية. ومع هذه الخصوصية، لم تعمل كلمة “معارضة” كما ينبغي أن تعمل نظرياً في العلوم السياسية.
بعد 2011، تغيّرت هذه المعادلة كلّها، فتغيّر الخطاب الذي كان يقاوم النظام البائد من عقلية المعارضة النخبوية الضيّقة الضعيّفة إلى الذهنية العمومية المفتوحة القوية التي يشارك فيها الكلّ. وتغيّر مكان الخطاب من أماكن مغلقة محدودة، مثل المنتديات وبيوت المعارضين، إلى مكان مفتوح في الشوارع والساحات. ولم تتمكّن المعارضة السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنّها ظلّت نخبةً أيديولوجيةً. ولم تتمكّن المعارضة طيلة السنوات الأربع عشرة من عمر الثورة من أن تُنجز شيئاً كبيراً بحقّ، ولم تتمكّن من نيل ثقة السوريين.
على أيّ حال، الآن سُحِق النظام، ونحن الآن في مرحلة انتقالية؛ فكيف نُفكِّر في مفهوم المعارضة في هذه المرحلة؟… نقترح أن معنى المعارضة في هذه المرحلة فيه ثلاث ركائز: الشراكة، والحماية، والكياسة. ويتناول كاتب هذه السطور بتكثيفٍ كلَّ ركيزةٍ على حدة. ونبدأ من الشراكة؛ ففي المراحل المصيرية، ومنها التي نعيشها اليوم، لا شراكة أفضل في البلاد من شراكة السلطة ومعارضيها. بل ثمّة ارتباط وجودي بين المفهومين، فالسلطة التي تدير البلاد الآن بموجب مخرجات مؤتمر النصر لا يمكن أن تكون إلا بوجود معارضة. وجود معارضةٍ لها يشرعنها، ويدعمها، ولكن عندما يكون للمعارضة معنى الشراكة، ليس بالضرورة الشراكة في السلطة (مع أنها مهمة)، لكن الشراكة في تقاسم الهموم الوطنية العمومية المشتركة كلّها، وفي أن يفكّر كلٌّ من الشريكَين من منظور الآخر دائماً، يتفهم مشكلاته، والمسائل التي تحدُّ من تحرّكاته برشاقة، ويساعد دائماً في حلّها. حان الوقت الآن ليعبر مفهوم المعارضة في سورية عتبةَ السياسة، وألَّا يبقى هذا المفهوم على العتبة كما كان، بل أن يدخل المجتمع السياسي للبلاد بوصفه شريكاً. وأيضاً أن تستمدّ المعارضة قوتها من السوريين مباشرةً؛ فتفهمهم دائماً، وتحلّل توجّهاتهم، وميولهم، وتبني ثقتهم بها، وتُعمِّقُ هذه الثقة باستمرار. ويتناسب هذا النوع من الشراكة عكساً مع الأيديولوجيا، فتزداد هذه الشراكة قوةً بضعف الأيديولوجيا وتضعف بقوتها، لأنها تحتاج إلى مقاربات وطنية منفتحة، وإلى تطوير قابلية التناغم مع الآخر لتحقيق الأهداف الكبرى. وأيضاً، يعني مفهوم الشراكة هذا أن يصير النقد حقيقياً، لا يكون بهدف النيل من السلطة، ولأغراض “المنفخة”، والاستعراض، ووضع العصي في الدواليب، بل يكون عقلانياً، وموجّهاً نحو هدف البناء، والتضامن من أجل المستقبل.
الركيزة الثانية هي الحماية، وتكون في ثلاثة مستويات. الأول أن تحمي المعارضةُ السلطةَ من نفسها، ومن احتمالات نشوب خلافات ضمنها، ومن أيّ نوعٍ من الغرور الذي قد يتسرّب إلى القائمين عليها. وهذه مفارقة، ولكنّها ضرورية في هذه الأيام التأسيسية من تاريخ البلاد، لضمان الاستقرار الملائم لبناء المؤسّسات، والدستور، وشكل الاجتماع السياسي السوري كلّه. والمستوى الثاني أن تحمي المعارضةُ المجتمعَ السوري من مفهوماتٍ قديمةٍ هدامة، مثل التكتّلات ذات الجذر الطائفي، أو القبلي، ومثل تمجيد السياسيين، ورفعهم خارج إطار النقد، وغيرها. والمستوى الثالث أن تحمي المعارضةُ نفسَها، من طغيان الأيديولوجيا، ومن التبعية للخارج، ومن المصالح الشخصية الضيّقة، ومن المال السياسي، ومن ظاهرة قديمة يعرفها أصحاب النيّات الطيّبة في أثناء فترة الثورة، وهي الانتهازية، والوصولية، التي ابتُليت بها معارضة النظام البائد السياسية منذ 2011، ومزج هذه الانتهازية مع المزاودة والاستعلاء على الطيّبين. ومن الانتهازيين من جمع أموالاً من ألم البشر (مغسولةً بعنايةٍ وخبث)، وطوَّروا نوعاً من الجشع والغرور الذي يتغذَّى على البؤس السوري. يعتقد هؤلاء الآن أنهم لا يزالون مؤهّلين لإعادة المراوغة، وإعادة تأهيل قلّة الشرف بخبثٍ وتلوّن يلائم كلَّ زمان ومكان. من هؤلاء جميعهم ينبغي حماية مفهوم المعارضة دائماً، وهذا بطبيعة الحال لا يكون من دون ضوابط أخلاقية (وربّما قانونية)، وشفافية تمنع استغلال هذه النقطة الأخيرة من دون أدلّةٍ واضحة، بحيث لا تصير حُجّةً تُستخدَم كيفما اتفق.
والركيزة الثالثة هي الكياسة، وهذه فكرة تتعلّق بتغيير أسلوب الهجوم اللاذع المُستفز، واللغة الشعبوية، والتشهير الرخيص، وتغليب العقل، والبعد الأخلاقي. وتجنب بناء جماعات ضغطٍ ذات مصالح ضيّقة وشخصية، من النوع الذي يستهدف النيل من فلان وعلان، أو الكسب المادي، أو التابعية لدولٍ، أو جماعاتٍ خارجية، أو مشاريع عابرة للحدود، وما إلى ذلك. تتعلّق الكياسة ببناء اللباقة في تدبير الاختلاف السياسي، وتطوير لغة تبني الثقة، والنيّات الطيّبة.
أخيراً، لا يجب (تحت أي ظرف) أن يتطلّب مفهومُ المعارضة في سورية الجديدة كثيراً من الشجاعة والاستعداد للتضحية، وأيّاً كانت السلطة، فإنها قد تصبح في يومٍ معارضة والعكس؛ فالمفهومان شريكان في الدلالة والأهلية.
العربي الجديد
———————————
تركيا وسورية وحدود الشراكة الجديدة/ محمود علوش
08 فبراير 2025
أسّست الزيارة الأولى للرئيس السوري المؤقّت أحمد الشرع تركيا أرضيةً لمشروع شراكة استراتيجية بين البلدين. ومن الانطباعات التي يُمكن أخذها عن الزيارة ونتائجها، أن هذه الشراكة ستكون لها خصوصية تُميّزها من الشراكات الأخرى التي يسعى الشرع لتأسيسها مع قوىً إقليمية مثل السعودية. وترجع هذه الخصوصية إلى الجوانب الأكثر حساسية في العلاقات التركية السورية الجديدة، مثل الدور الذي ستلعبه أنقرة في تأسيس وتأهيل وتسليح الجيش السوري الجديد، وإمكانية إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين الطرفين، تُتيح لتركيا تأسيس قواعد عسكرية لها في سورية، واستخدام مجالها الجوي لأغراض عسكرية، والدفاع عنها في مواجهة أي تهديد خارجي مُحتمل، فضلاً عن التصوّر السائد بأن تركيا ستلعب الدور الأكبر في عملية إعادة إعمار سورية.
سيستغرق الأمر بعض الوقت لاتضاح معالم هذه الشراكة وحدودها. مع ذلك، تُظهر أنقرة طموحاتها الواسعة في العلاقات الجديدة، وعلاوة على التعاون الدفاعي وتقاطع المصالح مع دمشق في مواجهة التهديد الذي تُشكّله وحدات حماية الشعب الكردية لوحدة الأراضي السورية، ولأمن تركيا، تتطلع أنقرة إلى إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدَين. ومثل هذه الاتفاقية ستكون لها انعكاسات كبيرة على الصراع الجيوسياسي مُتعدّد الأطراف في شرق البحر المتوسط. علاوة على ذلك، فإن مشروع الشراكة الاستراتيجية سيُعيد تشكيل توازن القوى على مستوى الشرق الأوسط، لجهة تعميق حضور تركيا قوةً فاعلة في الجغرافيا السياسية الإقليمية. وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإن المسار الذي ستسلكه العلاقات التركية السورية الجديد يحظى باهتمام ومراقبة كبيرين على المستوى الإقليمي والدولي.
بالنسبة إلى الشرع، فإن الشراكة الاستراتيجية مع تركيا لا تندرج في إطار الخيارات الجيوسياسية بقدر ما تُشكل حاجة لسورية، انطلاقاً من واقع الجغرافيا، وتأسيس تركيا حضوراً عميقاً مُتعدّدَ الأوجه في سورية خلال سنوات الصراع، فضلاً عن أن تركيا، وعلى عكس معظم الدول الإقليمية والدولية الأخرى، تتجنّب وضع أيّ شروط على الإدارة السورية الجديدة في مقابل التعامل معها، ودعمها، إلى جانب أنها تنظر إلى إنجاح تجربة التحوّل السوري على أنها حاجة أمنية لها ولطموحاتها الجيوسياسية. مع ذلك، يُظهِر الشرع قدراً كبيراً من الإدراك لواقع الجغرافيا السياسية الإقليمية والحاجة إلى تجنّب الانخراط السلبي فيها. وقد صمم اختيار السعودية أوّلَ وجهة خارجية له لإظهار رغبته في تنويع الشراكات الجديدة مع الإقليم، ولتأكيد أن العلاقة مع الرياض لن تكون على حساب العلاقة مع أنقرة، والعكس. وحقيقة أن سورية بحاجة اليوم إلى مثل هذا التوازن في الشراكات تُفسّر عملية الموازنة التي يُحاول الشرع القيام بها لتشكيل سياسة سورية الخارجية.
حتى الآن، تُظهِر السياستان التركية والسعودية في سورية انسجاماً كبيراً في الأهداف، لكنّ الطموحات قد تتعارض في نهاية المطاف. إن دافعاً رئيساً من دوافع الاحتضان السعودي للشرع يرجع إلى مسعى الرياض لتعظيم حضورها في سورية من أجل موازنة الحضور التركي، وستتوقّف قدرة الشرع في الموازنة بين السعودية وتركيا على حدود انسجام سياسات البلدَين وإدارة المنافسة بينها. وما يأمله الشرع أن تؤدّي رغبته في إفساح المجال للرياض وأنقرة لتعظيم حضورهما في سورية إلى تحصين إدارته الجديدة، من خلال احتضانها من قوتَين إقليميتَين، الأولى تُمثّل العمق العربي، وقادرة على التأثير في تشكيل السياسات الغربية في سورية، والثانية تُمثّل شريكاً استراتيجياً طبيعياً بحكم الجغرافيا، ودورها القوي في دعم الثورة السورية، وتلعب دوراً مساعداً في الحفاظ على وحدة سورية، وتقويض طموحات الوحدات الكردية.
علاوة على ذلك، ستُحدّد النظرة الأميركية إلى مشروع الشراكة التركية السورية حدود قدرة الشرع على الذهاب بعيداً فيها. لا يُمكن تقديم تصوّر دقيق للنهج الذي سيتبعه الرئيس دونالد ترامب في سورية، وسيحتاج الأمر بعض الوقت لمعرفة اتجاهاته العريضة، وأثرها في الحالة السورية، لكنّه يُظهِر رغبةً في تجنّب التأثير القوي في سياق التحوّل، ويميل إلى إبرام صفقة مع تركيا بخصوص ملفّ الوحدات الكردية. ومثل هذا الاتجاه (المُرجّح) سيُساعد في تقويض التحدّيات التي تواجه الشراكة السورية التركية. وبقدر ما يحتاج الشرع انخراطاً تركياً قوياً في دعم سورية الجديدة، ومساعدتها خصوصاً في الجوانب العسكرية، فإنه يحتاج أيضاً انخراطاً سعودياً قوياً في دعمه، وكذلك انفتاحاً غربياً واسعاً عليه لتفكيك العقوبات والعزلة التي تواجهها سورية. إن هذه العوامل مُجتمعة، ومساراتها في الفترة المقبلة، ستعلب دوراً مؤثّراً في توضيح حدود مشروع الشراكة الاستراتيجية التركية السورية.
تتركز أولوية أحمد الشرع في الوقت الراهن على تكريس السلطة الجديدة في الداخل، وتوفير متطلّبات نجاحها، وهي أولوية منطقية وملحّة في التحوّلات عموماً، وفي حالة سورية خصوصاً. وتعزيز التفاعل مع الخارج مُصمَّم بدرجة أساسية لخدمة هذه الأولوية. وإنتاج سياسة خارجية قادرة على توفير متطلّبات النجاح والموازنة في الشراكات مع تركيا والسعودية، وإقناع الدول الغربية بمزايا تفكيك سريع للعقوبات، والتوصّل إلى تسوية سياسية لمعالجة ملفّ الوحدات الكردية، سيختصر الكثير من المسافات على الشرع لتحقيق أهدافه، وعلى التحوّل السوري، لتعظيم فرص نجاحه في نهاية المطاف.
العربي الجديد
———————————
ثناء وشكر مستحقَين لسوريي ما بعد 7/12/ عمر قدور
السبت 2025/02/08
“إلى قيصر سوريا: فريد المذهان”
بعد مرور شهرين على سقوط بشار الأسد صار ممكناً الحديث عن سمات عامة لسلوك السوريين، بل من الضروري فعل ذلك. ولئن كان مفهوماً أن تتجه الأنظار إلى السلطة، ومراقبة أية نأمة تصدر عنها، فتعزيز ذلك لا يصبّ في المنحى الذي يريده السوريون. السوريون ثاروا بعد عقود من احتكار السلطة المقترن بالتعامل معهم ككائنات غير مرئية، وليس لها اعتبار حقيقي حتى عندما تُذكر ضمن إنشاءٍ بليد أجوف.
أشرنا سابقاً في أكثر من سياق إلى ما أظهره السوريون من حرص على السلم الأهلي، وهو ما يقتضي قليلاً من التفصيل اللائق بما حدث حقاً. فمنذ الساعات الأولى لسقوط بشار، بادر العشرات إلى الاستنفار لمنع مجازر طائفية محتملة، أو عمليات ثأر عشوائية. حدث هذا خصوصاً في مدن وبلدات شهدت في السنوات الماضية مجازر، أو أعمال عنف وخطف استثمر فيها الأسد للتخويف من حرب أهلية فيما لو سقط. وكأنّ الحرب لم تحدث بوجوده، وبإشراف حثيث منه.
اللوحة ليست ناصعة تماماً، فقد كانت هناك أعمال ثأر وانتقام، لكنها في الحد الأدنى، تحديداً من الناس العاديين، وهم نسبة عظمى من أولياء الضحايا. التنويه لا يستثني أولئك الذين طالهم الثأر، ولم ينزلقوا إلى ثأر مضاد. السلاح موجود بمتناول الجميع، والقدرة على استخدامه بلا رادع موجودة أيضاً، لكن السوريين بمعظمهم لم يفعلوا ومنحوا “الدولة” ثقتهم، رغم الإرث غير المشجَّع للدولة؛ منحوها ثقتهم على أمل أن تخالف السلطة الجديدة ما سبقها فتقود مسيرة العدالة، وبقوا على ذلك حتى عندما تسبّبت بالأذى عناصر منها قيل أنها تصرفت بلا توجيه.
في إجراء، له بُعد واقعي ورمزي، بادرت مجموعات هنا وهناك إلى تنظيف العديد من الأحياء السكنية إثر سقوط الأسد، أي أنهم لم ينتظروا التحسن المأمول للواقع الخدمي. وقد لا يعلم كثر أن السوريين منذ شهرين يتطوعون بتنظيم السير فيما بينهم حسب الحاجة، حتى في الأماكن التي تشهد عادة اختناقات مرورية حادة. لا وجود لشرطة سير في سوريا بسبب استغناء السلطة عن جهاز الشرطة القديم، وبلا بديل يتولى على الأقل الأماكن الأكثر ازدحاماً. في ظروف استثنائية، قد يتسبب شجار مروري في اندلاع أعمال شغب وعنف واسعة، وبعد مضي شهرين لم يُنشر أي خبر عن مشاجرة كبرى.
استغنت السلطة أيضاً عن الشرطة المدنية والجنائية، وفي ليلة إسقاط الأسد شهدت دمشق إطلاق سراح المساجين بلا تمييز، ومن المؤسف أن نسبة السياسيين بينهم إلى الجنائيين لم تكن الأكبر. حدث ذلك من قبل في مدينة حلب، والنتيجة أن أصحاب السوابق الجنائية استغلوا الفراغ الأمني لممارسة عمليات السطو، وعمليات الاختطاف بغرض الحصول على فدية.. إلخ.
تحمّل السوريون الضغط على أمنهم، الناجم عن سوء تدبير، يحدوهم الأمل بسدّ هذه الثغرة الخطيرة قريباً. وسوء التدبير طاول لقمتهم، إذ رُفع سعر الخبز مرتين منذ تولّت السلطة الجديدة الحكم؛ في المرة الأولى ارتفع السعر إلى عشرة أضعاف سعره السابق، وفي المرة الثانية نقص عدد الأرغفة وحجم الرغيف في الربطة التي حافظت على سعرها. ولم يكن حال الغاز المعدّ للاستخدام المنزلي بأفضل، فقد ألغي الدور الذي يمنح المكتتبين سعراً مخفّضاً، لتُباع الأسطوانة بسعر يعادل راتب شهر لبعض المتقاعدين.
الفئة الأخيرة لم تسلم من سوء التدبير، فأُخبر المتقاعدون في حلب مثلاً أن عليهم الإتيان بإخراج قيد جديد لمعاودة استلام رواتبهم في العهد الجديد، إلا أن العديد من دوائر النفوس مغلقة، أي أنهم بقوا بلا رواتب، والحديث هنا عن فئة تجاوز معظمها سنّ العمل. ورفع الأسعار، وعرقلة قبض رواتب بعض الموظفين، لا يستقيمان مع إعلان حاكمة المصرف المركزي توفر رصيد كافٍ لزيادة الرواتب 400%، بل إن وضعهما جنباً إلى جنب لا يعطي انطباعاً لصالح الحكم الجديد.
بالتزامن مع عدم إيلاء قضايا الأمن والمعيشة الاهتمامَ اللازم، انشغل المسؤولون الجدد بشكليات من قبيل تخصيص مدخل للنساء وآخر للرجال في جامعة حكومية، مع رقابة على الالتزام بالقرار. وأيضاً توجيه الكادر التدريسي إلى منع جلوس أطفال من الجنسين على المقعد نفسه في المدارس المختلطة، تحت طائلة المسؤولية! ذلك فضلاً عن صرف الجهد في ملاحقة المتحولين أو المثليين، في حين أنه مطلوب بإلحاح ملاحقة المجرمين الفالتين وشبيحة العهد البائد.
وصبرُ السوريين على “التناقضات” والعثرات التي تتخلل أداء العهد الجديد لا يرجع إلى خوف منه، موروثٌ من ثقافة الخوف السابقة عليه. صحيح أن معظمهم قد استُضعف في العقد الأخير أكثر من أي وقت مضى، تحت سيطرة الأسد أولاً، وتحت سيطرة الفصائل التي كانت مناوئة له ثانياً، لكنهم يدركون أن السلطة بدورها في أضعف حالاتها. ومع إدراكهم ذلك يريدون لها النجاح، لا حبّاً بها، وإنما من أجلهم ومن أجل البلد، مع التنويه بأن معظم السوريين أنضج من التفكير في العلاقة مع السلطة على قاعدة الحب أو الكره التي يُفترض أن مكانها هو العلاقات الشخصية لا السياسة.
كتعبير عن النضج، ومنذ الأيام الأولى على إسقاط الأسد، انبثقت مبادرات عديدة من أجل الانتظام في تيارات سياسية ولجان مدنية، يدرك أصحابها أن التخلص من تركة الأسد يكون بالعمل السياسي، وبأن يأخذوا زمام المبادرة. وهي خطوات لا تكون ضد السلطة، إلا عندما تكون الأخيرة عازمة على احتكار الفضاء العام. أما إذا كانت النية معقودة على التحول الديموقراطي فالمطلوب ملاقاة تلك المبادرات، وبالتأكيد هناك خطوات لا تصب إطلاقاً ضمن المطلوب، مثل تعيين مجالس جديدة للنقابات، بينما من المنطقي أن تدعو السلطة النقابات المعنية إلى إجراء انتخابات حرة.
الحديث دائماً هو عن شعب أُنهك بعقود من الاستبداد والقمع، ثم بوحشية هائلة منذ اندلعت الثورة، وهذا الشعب أظهر خلال الشهرين الأخيرين أفضل ما يمكن توقعه. والقول أنه يستحق الثناء والشكر ليس إطلاقاً من باب الشعارات أو التصدّق عليه، فالسلطة مدينة له بذلك لأن أداءه ساعدها في أحرج الأوقات، ومدينة له بالاعتذار عن التقصير وعن الأخطاء، لأن من واجبها فعل ذلك حتى إذا لم تُطالَب به.
الأهم من لياقات الثناء والشكر، أن السوريين برهنوا على أهليتهم، رغم عقود من التعامل معهم كقُصَّر، وهي مسألة تتجاوز الظروف الحالية إلى ضرورة التعاطي معهم كذوات سياسية كاملة الحقوق، أي أنهم يستحقون بجدارة أن يكونوا شركاء في إدارة شؤون بلدهم كأقلّ تعويض مستحَق لهم؛ هذا ما لا يريد رؤيته المنتمون إلى ما قبل الثامن من ديسمبر بكافة مشاربهم.
المدن
————————————-
ما لأكراد سوريا وما عليهم/ ناصر زيدان
السبت 2025/02/08
إشكالية ملف المواطنين الأكراد السوريين، تتجاذبه مُسميات متعددة، منها يحمُل توصيفات مُجحِفة بحقهم، عندما يقال عنهم مُتمردون او انفصاليون، ومنها يسمي الوقائع كما هي بإعتبار ملفهم قضية لا بد من معالجتها بحكمةٍ وروية، بينما يبالغ البعض منهم في إظهار المظلومية في سياق عرضه للمطالب، ويتعاملون كون السلطة الجديدة في دمشق تمثل جهة واحدة، ومطلبهم بالاستقلال حقاً مُبرراً، ودونه لا حلّ للإشكالية.
أكراد سوريا الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن، تعرَّضوا لتهميش لا يمكن إنكاره، وحُرموا من ممارسة خصائصهم القومية والثقافية، ووضعهم المعيشي كان غير مُريح على الإطلاق، برغم أن دستور حزب البعث العربي الاشتراكي السابق؛ لم يلحظ أي تمييز بين المواطنين، وأنشد المساواة بينهم في النصوص، لكن في الممارسة كان الوضع مختلف تماماً، وعاش السوريون بغالبيتهم الساحقة في حالة من القهرِ والإذلال، وحرموا من أبسط الحقوق، ولم يقتصر التجنِّي على الأكراد فقط.
بعد انتصار الثورة السورية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، اعتلت القضية الكردية إلى السطح بقوة. فهناك جهات اعتبرتهم عقبة في وجه وحدة البلاد واستعادة عافية مؤسساتها الدستورية، لأنهم رفضوا الاندماج مع الإدارة الجديدة حتى الآن، وهم يملكون قدرة عسكرية لا يُستهان بها، ومنظَّمة من خلال قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفيها آلاف من المجندين العرب والسريان إضافة الى الأكراد، وهي تسيطر على مساحات واسعة من شرق البلاد وشمالها، وهذه القوات لم تكُن على وفاق مع فصائل إدلب التي نجحت مع فصائل الجنوب في تنظيم عملية “ردع العدوان” التي أسقطت النظام، لكنهم لم يكونوا من المنظومة التي كانت تدور في فلك النظام البائد، بل على خصام معه. بينما الغالبية من الأكراد فرِحوا لفرار الأسد، واعتبروا زواله فرصة لاستعادة بعض الحقوق البديهية التي حرمتهم منها تجربة البعث على مدى زمنٍ يزيد عن نصف قرن.
الفرصة المُتاحة لتحسين وضع الأكراد بعد سقوط النظام في سوريا؛ قد تتحوّل الى مناسبة لتراجعات دراماتيكية إذا لم يُحسن المعنيون إدارة الملف، والمسؤولية عن ذلك لا تتحملها إدارة سوريا الجديدة في دمشق وحدها، بل الجزء اليسير منها يقع على عاتق قيادة قسد، حيث البعض منها اعتاد التفرّد بالسلطة على مساحة تقارب ثلث الأراضي السورية. لكن المُريح في الأمر هو استمرار التواصل بين الادارة السورية الجديدة وقيادة قسد، حتى أن اتصالاً هاتفياً حصل مباشرةً بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، وكان إيجابياً على ما نقل مقربون منهما.
الخلاف بين الإدارة المركزية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، ينحصر بطلب الأكراد اعتماد نظام فيدرالي، يُعطي هؤلاء حق إدارة لامركزية في مناطقهم، ولا تصل الى حد الإدارة الذاتية، كما في كردستان العراق، وأن يعود تسمية الجمهورية على ما كان في السابق، أي “الجمهورية السورية”، وإدخال فصائل قسد في جيش سوريا الجديد كمجموعات وفقاً لتنظيمهم القائم اليوم. لكن الحكومة الانتقالية في دمشق تعتبر أن تغيير النظام وتسمية الدولة من اختصاص المؤتمر العام المُزمع عقده في الفترة القريبة اللاحقة، أما موضوع الجيش، فقيادته ترفض الانتساب إليه كمجموعة منظَّمة، بل تشترط التطوّع الفردي فيه، وما ينطبق على عناصر قسد، ينطبق على الآخرين من دون أي تمييز، وهذا الموقف حصل أيضاً مع فصائل محافظة السويداء الذين تمنعوا عن تسليم سلاحهم للجيش حتى الان.
دخل زعيم إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على خط الوساطة، ويبدو أن تحرُكَهُ جاء بتنسيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استقبل البرزاني بعد جفاءٍ طويل بينهما. وتركيا ترفض بالمطلق أي استقلال للأكراد في سوريا، كما رفضته سابقاً لأكراد العراق، لأن ذلك يعني مطالبة أكراد تركيا بالمثل، وهؤلاء يشكلون العدد الأكبر من أكراد المنطقة، ويزيد عددهم في تركيا على 14 مليون مواطن. والبرزاني استدعى قائد قسد مظلوم عبدي، وأبلغه بالمعطيات الخطرة التي قد تجعل من أكراد سوريا ضحية أمام لُعبة الأُمم، لأن تركيا وحكومة دمشق الجديدة لن يقبلا بأي مطالب انفصالية، وسيتدخلان بالقوة لإنهاء أي تمرد كردي، والولايات المتحدة التي كانت تحمي قسد وتدعمها مالياً؛ لن تتدخل هذه المرَّة، والظروف التي جعلتها تتمسك بقسد لمحاربة “داعش”، تغيرت، والقوات الأميركية على مشارف الانسحاب من قاعدتيها في سوريا.
إلهام أحمد مسؤولة العلاقات الخارجية في إدارة المناطق الشمالية الشرقية؛ طالبت بتدخُل إسرائيل لمنع هزيمة الأكراد، لكنها عادت ونفت ذلك، مؤكدةً أن حديثها لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تمّ تحريفه، وهذا النفي لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام في التفاوض مع حكومة دمشق، والتوتر قد ينحو باتجاهات أمنية خطرة، وتأكد ذلك عندما انفجرت سيارة مُفخخة مطلع الشهر في مدينة منبج، شرق حلب، وأدت الى مقتل 20 شخصاً وجرح 20 آخرين، والسيارة قدِمت من مناطق سيطرة قسد، وقد توعَّد الرئيس أحمد الشرع بالاقتصاص من الجهات التي تقف خلف هذا العمل. علماً أن المناطق التي تسيطر عليها قسد، فيها أعداد كبيرة من المواطنين السوريين العرب والتركمان والسريان، والأكراد ليسوا أغلبية مطلقة فيها.
للأكراد في سوريا الحق في رفع المظالم التي تعرِّضوا لها في السنوات الطويلة الماضية. كما لهم الحق في الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم وعلى مكانة في مؤسسات الحكم في سوريا، ولكن عليهم أن يقبلوا بالواقع الجيوسياسي الذي يفرض الحفاظ على وحدة سوريا، واحترام التنوَّع الموجود في مناطق نفوذهم، وفي أن ثروات هذه المناطق ملكاً للشعب السوري برمته.
المدن
———————————-
واقع السوريين الأكراد السياسي من الثورة إلى إسقاط النظام/ شفان إبراهيم
07 فبراير 2025
تتطلّب سلسلة التحوّلات الجذرية، التي أحاطت بالقضية الكردية في سورية، منذ نهايات السلطنة العثمانية، حتى لحظة انعتاق البشرية من أحد أسوأ أنظمة الحكم، حلولاً، وليس مُجرَّد سرديات عن انضمامهم جزءاً إلى الكلّ الذي يعود إلى دائرة مفاهيم المركزية، والهويّة السورية، جزءاً من الأمّة، والحضارة العربية.
وإذا حُصِرت مفاهيم الوطنية والانتماء بمعارضة النظام، فإن الكرد مارسوا كُلّ ما استطاعوا إليه سبيلاً في طريق الخلاص، أو على الأقل الثبات على الهُويَّة والوجود واللغة والتاريخ الكردي، جزءاً أساساً من القضية الوطنية السورية، وحملوا لواء المعارضة منذ بواكير نشأة الدولة السورية، والاستقلال الأول عن الفرنسيين، ويكفي الاستدلال بأسباب (ونتائج) تشكيل الجمعيات والأحزاب الكردية، في منتصف خمسينيّات القرن الماضي، دليلاً على معارضة حكم البعثيين البلاد، وما تلاها من أحكام قاسية ضدّ الكرد، التي وصلت إلى الاعتقال عشرات السنين، ردّاً من النظام على رفض الكرد التبعية والانخراط ضمن مشاريع الصهر والإلغاء، إضافة إلى تحطيم تمثال حافظ الأسد وكسره في عامودا والقامشلي، حين كان النظام في أوج قوته وبطشه وجبروته، إبّان الانتفاضة الكردية في 2004.
الموقف من الثورة
توزَّع الكرد بين طرفَين وموقفَين إبّان الثورة السورية. في بدايات الحراك الشعبي في عام 2011، اختار الشارع الكردي والمجلس الوطني الكردي الوقوف في جانب السوريين في محنتهم، والانخراط ضمن الإطار الوطني السوري، بدلاً من الاصطفاف بجانب النظام، أو معاداة الثورة، أو مواجهة الثوّار، في مقابل اختيار الاتحاد الديمقراطي، ثمّ الإدارة الذاتية، مفاهيم الخطّ الثالث، وما استتبعه من سلسلة مشاريع وأفكار، لم تنجح في تطبيقها أو تقبّل السوريين لها.
تلا ذلك انقسام الكرد في سورية بين محورَين: الأول، المجلس الوطني الكردي، المنضمّ إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وأصبح جزءاً من هيئة التفاوض مكوّناً مستقلاً، وممثّلاً في اللجنة الدستورية، وتمكّن من الحصول على وجود (وإن غير قوي بالشكل المطلوب والكافي) للتمثيل السياسي الدولي، عبر لقاءات مع وفود دولية، وعضويته في المعارضة السورية، وعلى علاقة جيّدة مع تركيا، صاحبة اليد العميقة في الملفّ السوري، وخاصّة في الشمال الغربي، ومع التفضيل الأميركي أنقرة على حساب القوى الأخرى كافّة. كما تلقّى المجلس الكردي الدعم والمساعدة والمساندة المعنوية والسياسية واللوجستية من قيادة إقليم كردستان العراق. في المقابل، طرح الاتحاد الديمقراطي سلسلة مشاريعَ وأفكارٍ وقضايا، من قبيل “أخوة الشعوب”، و”الأمة الديمقراطية”، و”الإدارة الذاتية”، التي تعرّضت للتغيير في هيكليّتها وتسمياتها مراراً، وصولاً إلى طرح عقد اجتماعي من طرف واحد، وما سبقه من اجتماعات وملتقيات خاصّة بهم، في كلّ مرّة يُطرح أي مشروع أو قضية حول سورية.
وفي المجمل، أثبتت جميعُها عدم نجاحها أو عدم ملاءمتها لطبيعة المجتمع السوري عامّة، والكردي خاصّة. وامتلك هذا الجناح قوّة عسكرية تحوّلت جزءاً من التحالف الدولي، بقيادة أميركا، لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ورغم ما قدّمته من ضحايا، ودحرها القوى التكفيرية المتمثلة بـ”داعش”، ومع سيولة مساعي الإدارة الذاتية أو مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لتقديم أوراق اعتمادها طرفاً سياسياً وإدارياً، سواء لتركيا، أو لحوار مع النظام السوري، أو لمسارات الحلّ السياسي في جنيف وأستانة وسوتشي، لكنّ الفيتو التركي من جهة، ورفض المعارضة السورية من جهة ثانية، وممارساتها في أرض الواقع من جهة ثالثة، حالت دون تحقيق أي تقدّم، أو كسرٍ لطوق العزلة حولهم.
واقع الإحاطة المقتضبة والمكثّفة أعلاه، كمنت خلف تباينٍ في مواقف السوريين تجاه طرفي الصراع الكردي، الذي هو في صُلبه صراعٌ هُويَّاتي، ما بين الانتماء إلى الأمّة الكردية، والانتماء للثورة، والموقف المُسالم من تركيا، والانخراط في مشاريع المجتمع الدولي، وما بين “فكرة” الخطّ الثالث، ومحاولة فتح قنوات التواصل مع أكثر من طرف متناقض، وعدم معاداة النظام وإيران. وفي المحصّلة، الذاكرة السورية مُتخمة بمواقف الأطراف من الثورة، وهي في أوج الحاجة إليهم. مع ذلك، فإن أفضل الحلول هو التوافق والابتعاد عن شبح الحرب.
اختلاف الرؤى والمصالح
وعبر سياق الأحداث وتطوّرها، يُطرَح بشكل مستمرّ مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الكردي، الذي يعتمد على جملة من العوامل السياسية والعسكرية المتداخلة مع تحوّلات الوضع السوري داخلياً وإقليمياً، وراهن حال الطرفَين، خاصّة في ظلّ تعارض تكوين كل منهما وخلفيتهما السياسية.
تتألف “قسد” من تحالف عسكري يضمّ وحدات حماية الشعب التي أسّسها الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى فصائل عربية وسريانية، وتشكّلت عام 2015 بدعم أميركي، وخاضت معارك ضدّ تنظيم داعش في عموم شمال شرقي سورية. في المقابل، لم تحظ بأي حماية من الفواعل الرئيسيين في الملفّ السوري (أميركا وروسيا) خلال المعارك التي خسرتها مع فصائل المعارضة السورية، المدعومة من تركيا في عام 2018 في عفرين، و2019 في رأس العين وتلّ أبيض، وتدعو مظلّتها السياسية، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إلى مفاهيم تتعلّق بالأمّة الديمقراطية، والعيش المشترك، بعيداً عن القضايا القومية، التي تصفها بفاقدة الصلاحية.
أمّا المجلس الوطني الكردي، فهو تجمّع سياسي يضمّ عدة أحزاب كردية سورية، وتأسّس في 2011. يقول في بياناته ومواقفه إنه يسعى إلى تمثيل المصالح القومية للكرد السوريين في المحافل السياسية الدولية، ويعمل على تعزيزها في سورية، ولكن ضمن إطار وحدة الأراضي السورية، وفق نظام لا مركزي يمنح الأطراف صلاحياتٍ تتعلّق بالأمن والاقتصاد والتمثيل السياسي. يرتبط المجلس بعلاقات قوية مع المعارضة السورية، التي تعتبره ممثّلاً شرعياً للكرد في سورية، ما يضعه في موقف معارض لـ”قسد”.
محاولات رأب الصدع
خلال عمر الثورة السورية، سعى رئيس إقليم كردستان (آنذاك)، مسعود البارزاني، إلى تقريب وجهة نظر الأطراف الكردية، عبر أربع اتفاقيات، سمّيت وفق المكان الذي عُقدت فيه، أوّلاها اتفاقية هولير الأولى (11/6/2012) لضمان العمل المشترك والاتفاق على رؤية سياسية موحدّة، لكنّ الخلافات وإعلان الاتحاد الديمقراطي هياكل خاصّة بمفرده، أدّى إلى مشكلات، فتوقّف العمل بالاتفاقية. ومع اقتراب عقد مؤتمر جنيف 2، سعت قيادة إقليم كردستان العراق إلى تشكيل وفد موحّد ومستقلّ لتمثيل الكرد في المؤتمر، أو تمثيل أي طرف يحضر جنيف للطرف الغائب، وعقدت اتفاقية هولير 2 (17/12/2013). لكن الاتفاقية لم تستمرّ سوى شهر، مع توجّه الاتحاد الديمقراطي، وعبر مجلس الشعب غربي كردستان، الذي أسّسه سابقاً (12/6/2011)، للإعلان عن الإدارة الذاتية من طرف واحد فقط. حدث ذلك في 21/1/2014، أي قبل يوم من انعقاد مؤتمر جنيف 2، وغاب عنه حزب الاتحاد الديمقراطي في ظلّ عدم وجود توافق أميركي روسي بخصوص التمثيل الكردي في المؤتمر، إذ رغبت واشنطن بحضور الكرد ضمن وفد المعارضة، لأن المجلس الكردي قد انضم إلى الائتلاف، إلى جانب اعتراض تركي على وجود حزب الاتحاد الديمقراطي، بوصفه ذراعاً لحزب العمّال الكردستاني. بينما دفعت روسيا ومجلس الشعب في غرب كردستان باتجاه قبول الحزب طرفاً ضمن جنيف 2، يمثّل الكرد، بهدف إحداث ضغط على تركيا والولايات المتحدة. وفي النهاية، فشلت روسيا في مساعيها.
استمرّت القطيعة بين الجانبين، حتى نهايات عام 2014، مع سيطرة تنظيم داعش على الغالبية المطلقة من كوباني (عين العرب)، في هذه الأثناء، دعا رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، إلى عقد اتفاق جديد بين كرد سورية، وأُعلِنت اتفاقية دهوك برعاية البارزاني والأميركيين (22/10/2014)، ووضع شرط الوصول إلى اتفاق للحصول على الدعم الأميركي في محاربة “داعش”. وبالفعل، ألقت الولايات المتحدة أول شحنة من الأسلحة من الجو للمقاتلين في كوباني (20/10/2014)، بالتزامن مع بدء قوات بشمركة إقليم كردستان العراق دخول تركيا (29/10/2014)، ووصلت طلائعها كوباني (31/10/2014)، لكن سرعان ما أُنهي العمل بهذه الاتفاقية، سواء بسبب الخلافات التي ظهرت في تمثيل الأطراف ضمن المرجعية السياسية الكردية، التي أعلنتها الاتفاقية، أو لتوجه الإدارة الذاتية إلى فرض التجنيد الإلزامي (1/11/2014)، وإجراء انتخابات البلديات في الحسكة (13/3/2015)، والتي اعتبرها إقليم كردستان متعارضة مع مضمون اتفاقية دهوك المبرمة بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، واصفاً إياها بـ”الخطوة المتفرّدة”، ومشيراً إلى أنها “غير مقبولة”، لينتهي العمل بالاتفاقية ومُلحقها أيضاً.
والملاحظ في الاتفاقيات الأربع الاتفاق بالمجمل على رؤية سياسية مشتركة، والبحث في آليات ضمن المجلس للإدارة الذاتية، لتكون معبّرة عن تطلّعات جميع الأطراف السياسية والشعبية الكردية، والاتفاق على طريقة عودة بشمركة روج آفا (غرب كردستان) للدفاع عن المنطقة. لكن، ووفقاً لبيانات ومواقف قيادات المجلس الكردي، فإن الإدارة الذاتية خلال أول منعطف أو لحظة، وبعد استثمارها السياسي للحوارات والنقاشات، تتنصّل من متابعة الحوار، وتقوم بتجريده من محتواه.
وفي عام 2019 شهدت مدينة القامشلي اجتماعات مكثّفة بين الطرفَين الكرديَّين برعاية دولية، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية ضامناً لأحزاب الإدارة الذاتية، وعلى قاعدة اتفاقية دهوك، لكنّها توقفت بعد عدة أشهر من الحوارات والتواصل.
البارزاني على الخطّ
خلال حملة ردع العدوان، بدا واضحاً أن إقليم كردستان العراق لن يقف مكتوفاً حيال ما يجري، وتحديداً دعمه السوريين الكرد، وحقوقهم في سورية. وبعد سقوط النظام، فإن كثيراً من الحركية الفاعلة التي لجأ إليها الإقليم، أوضحت حجم القوة سواء لتركيا، وللكرد في سورية، ورُبّما للإدارة السورية الجديدة أيضاً.
لجأ البارزاني إلى ثلاثة ملفّات مترابطة، دعم المجلس الكردي، عبر دعوته إلى اجتماع عاجل، عقب اجتماع الأخير مع وفد من الفرنسيين والأميركيين، بعلم البريطانيين وموافقتهم على الرسائل الدولية للكرد، وأرسل البارزاني مسؤول الملفّ السوري والكردي في ديوان رئاسة الإقليم، حميد دربندي، برفقة المبعوث الأميركي، ومبعوثاً للرئيس البارزاني للقاء مظلوم عبدي قائد “قسد”، والمجلس الكردي، وبدا واضحاً أن رسائل سياسية جدّية تقف خلف الزيارة، تلاها زيارة مظلوم عبدي للقاء البارزاني. ومجمل التحرّكات الدبلوماسية والسياسية لإقليم كردستان، تقود إلى ثلاثة ملفّات متشابكة، أولها أن تركيا سيكون لها شأن كبير في سورية، ولا نية للمجتمع الدولي في معارضة أي عملية عسكرية تقوم بها، لذا لا بدّ من خروج قوات العمّال الكردستاني من المنطقة. وثانيها الانفتاح المشترك على أحمد الشرع، وتشكيل وفد كردي مشترك. وثالثها أنه لا مجال للاستمرار في سياسية إقصاء الآخر، وأن توازنات البارزاني ستكون في خدمة كرد سورية بشرطين: التوافق الكردي الكردي، وتوافق الكرد مع باقي المكوّنات. والواضح أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أدرك حجم الضغط الدولي، وتجاوز القضية والمواقف حجم “قسد”، وحجم الإدارة الذاتية، وأن مستقبلهم مرهون بمدى موافقة البارزاني على تصرّفاتهم.
خاتمة
انتهت حقبة الأسدَين (الأب والابن)، وحقبة/ مرحلة الثورة، بانتصار ورُفع العلم الأخضر، في مختلف المدن السورية، وفي القامشلي أيضاً، وأصبح الكرد أمام واقع جديد، يجب فيه البدء بالشق السياسي والدبلوماسي، ففي المعركة المقبلة لن تُستخدَم البنادق ولا الجيوش، فثمّة إرادة دولية ستمضي صوب المنشود، ومن الواضح أن رغبة دولية تقود إلى قطع العلاقة بين “قسد” و”العمّال الكردستاني”، إضافة إلى ضرورة توحيد الرؤية من مجمل القضايا المتعلّقة بالأمن والاقتصاد، ونظام الحكم، وشكل الدولة، خاصّة أن البند الأساس المشترك، والمتّفق عليه في جميع الحوارات كان الرؤية السياسية التي يطالب بها الكرد، واعتبار مناطقهم وحدة جغرافية سياسية متصلة. وفي ظلّ إصرار الإدارة السورية الجديدة، ورئيسها الشرع، على حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وإخراج العناصر غير السورية من “قسد”، فإن أفضل الحلول هو وفد كردي مشترك، وفق المتطلّبات والضرورات التي تمليها المرحلة، والشروط الدولية والسورية. وبالعموم، فإن الحديث عن اتفاق الكرد فيما بينهم صعب للغاية، ما لم تفرضه أطراف فاعلة في الملفّ السوري (أميركا وبريطانيا وفرنسا). والخروج بضواغط وضمانات للتنفيذ. فعبر المراحل السابقة، وعقب كلّ اتفاق، كان الواضح توجّه المنظومة السياسية والعسكرية للإدارة الذاتية إلى الاستغلال المرحلي لها، في حين أن المجلس الكردي، ورغم شخصيته الاعتبارية، لم يستطع تحريك المياه الراكدة، والخروج من نسق الترهل الذي يعانيه، وهو بحاجة ماسّة لتغيير قوانين العمل التنظيمي لديه، خاصّة وفقاً للقوة التنظيمية والسياسية، ولنقاط القوة للأحزاب المنضوية فيه، وهذه الوحدة السياسية ستحمي “قسد” وإدارة المنطقة، وتضمن عودة قوات بشمركة روج آفا، والشراكة مع باقي المكوّنات، التي لا مفرّ من الشراكة معها، والحفاظ على حقوقها.
العربي الجديد
———————
الفرصة الأعظم لتركيا وسوريا منذ سقوط الدولة العثمانية/ سمير العركي
7/2/2025
احفظ المقالات لقراءتها لاحقا وأنشئ قائمة قراءتك
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس السوري أحمد الشرع يتصافحان خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في أنقرة (الفرنسية)
“لقد تمّ فتح صفحة جديدة ليس في سوريا فحسب، بل في منطقتنا بأكملها، بعد 13 عامًا من الدماء والدموع”.
هذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السوري، أحمد الشرع، في أنقرة، لخّصت الآثار الإستراتيجية المرتقبة لانتصار الثورة السورية، وتطبيع علاقة الدولتين.
من هنا كان احتفاء تركيا واضحًا بزيارة الشرع في الرابع من فبراير/ شباط الجاري، والتي جاءت بعد ساعات من زيارة مهمة مماثلة للسعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقبل الزيارتين بأيام قليلة في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حطت طائرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دمشق، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
هذه الفعاليات الرئاسية المتعاقبة، عكست تنسيقًا تركيًا- قطريًا- سعوديًا، في الملف السوري والإيمان المشترك بضرورة دعم النظام الجديد وتثبيت أركانه حتى لا يتعرض لانتكاسة تضر بالأمن الإقليمي ضررًا بالغًا.
في هذا الإطار، نستطيع قراءة زيارة الشرع لتركيا، وطرْح عدد من الأسئلة المحورية بشأن إعادة تعريف العلاقة بين الدولتين، وما يمثله إعادة الإعمار من أهمية إستراتيجية لتركيا، وصولًا إلى الملف الأهم المتعلق بالدفاع والأمن، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التعاون المرتقب على تعزيز الأمن الإقليمي.
إعادة تعريف علاقة البلدين
تم اختزال مفهوم “الشرق الأوسط” في الكتابات العربية، في نطاق جغرافي، يشمل تقريبًا الدول المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية دون غيرها.
ذلك التوصيف كان مطلوبًا بفعل الضغوط الاستعمارية، لتأكيد الانفصام مع الميراث العثماني، ونشوء ما عرف بالدولة القومية “الحديثة”.
في المقابل، فإن العديد من المصادر الغربية عرّفت منطقة “الشرق الأوسط” استنادًا إلى معيارين؛ الأول: المعيار الجيوثقافي المعتمد على الإسلام باعتباره الدين الذي يمثل غالبية شعوب المنطقة، أما المعيار الثاني: فكان يستند إلى الميراث التاريخي المشترك الذي خلفه العثمانيون.
هذا التعريف يوسع منطقة الشرق الأوسط، لتشمل تركيا الحالية، ويمتد إلى ألبانيا والبلقان باعتبارها مناطق ذات إرث إسلامي وعثماني لا يزال موجودًا حتى الآن.
ومع سقوط نظام الأسد البعثي، من المهم أن تعمل الدولتان على بناء سردية جديدة لتعريف علاقة البلدين، تتجاوز السرديات المغلوطة التي شكلت وعي أجيال متعاقبة في كلا الطرفين، إزاء الروابط التاريخية والثقافية التي تربطهما.
ووَفقًا لما أكده أردوغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشرع، عن تطوير العلاقة الثنائية “بشكل متعدد الأبعاد وفي جميع المجالات، بدءًا من التجارة إلى الطيران المدني، ومن الطاقة إلى الصحة والتعليم”، فإن تنقية مناهج التعليم في كلا البلدين من جميع التحيزات والتأويلات العنصرية المرفوضة، تمثل أولوية إستراتيجية لبناء فصل جديد ومهم في علاقة البلدين وتاريخ المنطقة.
وهنا يجب الإشارة إلى الخطوة التي أقدمت عليها أنقرة، باعتقال رئيس حزب ظفر “النصر”، أوميت أوزداغ، على ذمة اتهامات بترويج خطابات عنصرية تهدف إلى نشر الكراهية.
ومن المعروف أن أوزداغ قاد خلال السنوات القليلة الماضية، حملة واسعة لاستهداف وجود اللاجئين السوريين في تركيا، أدت إلى بعض أعمال العنف بحقهم، آخرها في ولاية قيصري في يوليو/ تموز الماضي.
فاعتقال أوزداغ وآخرين معه، كان رسالة واضحة من الحكومة التركية، أنها قد تتأخر لحساسيات داخلية، لكن لا يمكنها تجاوز ما حدث بحق السوريين من دعايات عنصرية.
كما أن إعادة تعريف علاقة البلدين يجب أن تستحضر التاريخ المشترك للشام والأناضول، منذ عهد السلاجقة مرورًا بالعثمانيين، وأيضًا يجب عدم إغفال التداخل العرقي المتبادل والعابر لحدود الدولتين والمتمثل في الوجود العربي والكردي والتركماني في كل من سوريا وتركيا، وأيضًا حضور الأغلبية السنية، إضافة إلى الطائفة العلوية في الدولتين.
ومع إضافة حدود مشتركة تربو على 900 كيلومتر، فنحن هنا إزاء مساحة جغرافية تقترب من مليون كيلومتر مربع، وعدد سكان يزيد على مائة مليون نسمة، ما يعني أننا أمام تشكل تعاون إستراتيجي جديد، سيكون له حضوره القوي في ملفات المنطقة المضطرية.
إعادة إعمار سوريا
تولي تركيا إعادة إعمار سوريا أولوية قصوى، حيث أكد أردوغان في تغريدة على منصة “إكس” استعداد بلاده “لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا”.
كما عزز وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هذا المعنى في تصريحات لوكالة الأناضول بقوله: “رئيسنا أردوغان قائد سياسي، كان دائمًا ما يولي اهتمامًا خاصًا للقضايا الاجتماعية والخدمات العامة منذ أن كان رئيسًا لبلدية إسطنبول، وهو قادر على فهم الوضع الذي يمر به الشعب السوري بكل تفاصيله”.
وأهمية ملف إعادة الإعمار لا تتوقف عند فاتورته التي قد تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار، ولا تقتصر على الأبعاد الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى عدة نواحٍ إستراتيجية التي تهم البلدين وأهمها:
أولًا: إعادة الإعمار ستوفر البنية التحتية اللازمة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري، واستئناف النشاط التجاري، ما يعني تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، وهو ما أشار إليه وزير التجاة التركي، عمر بولات مؤخرًا.
ثانيًا: أيضًا ستوفر إعادة الإعمار الفرصة أمام عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم التي هجروا منها، وهذا الملف لا تقتصر أهميته لدى تركيا على كونه سيحل مشكلة داخلية لديها، بل إلى أبعاد إستراتيجية أوسع وأشد أهمية. فالهجرة الواسعة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الثورة كانت من مكون واحد تقريبًا هو العرب السُّنة، ما أدى إلى خلل كبير لصالح مكونات عرقية ومذهبية أخرى تمتلك أجندات ومشاريع هوياتية وانفصالية مثلت تهديدًا للأمن القومي التركي.
ثالثًا: كما ستعمل إعادة الإعمار على تقوية دعائم نظام ما بعد الأسد، وهو ما يعد هدفًا إستراتيجيًا لأنقرة خلافًا لما يدعيه البعض من رغبة تركيا في بقاء سوريا ضعيفة.
فأنقرة يهمها تقوية الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، لتتمكن من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي السورية، والقضاء على التنظيمات الانفصالية، التي تعد خطرًا إستراتيجيًا على تركيا أيضًا.
تقوية الأواصر الدفاعية
خلّفت سنوات الثورة مشاكل أمنية عميقة ليس في سوريا وحدها، بل في المنطقة كلها وخاصة تركيا.
فالفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب نظام الأسد من مناطق في الشمال، تم ملؤه بتنظيمات انفصالية “كردية”، تابعة لحزب العمال، مما شكل تحديًا أمنيًا خطيرًا لأنقرة.
إضافة إلى احتلال تنظيم الدولة مساحات واسعة في شمال سوريا، ما أدى إلى تأسيس تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.
ولم يكن الأمر مقتصرًا على الجيوش الغربية وحدها، فقد جلب نظام الأسد القوات الروسية لحمايته، ومن قبلها استدعى الحرس الثوري الإيراني والمليشيا المنضوية تحته.
والآن تضع تركيا هدفًا معلنًا وهو تفريغ المنطقة من الجيوش الغربية، وتأسيس تحالف تركي – عربي لمواجهة أي تهديد محتمل من تنظيم الدولة، بحيث يتم القضاء على أي ذريعة لوجود تلك القوات الأجنبية.
من هنا تولي أنقرة ملف الأمن والدفاع في سوريا أهمية قصوى، وفي مقدمته إعادة بناء الجيش.
ففي نفس يوم زيارته أنقرة، نشرت رويترز نقلًا عن مصادر أن الشرع سيناقش مع أردوغان، إنشاء قواعد تركية جديدة وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري، وأن المحادثات قد تتطرق إلى توقيع اتفاق دفاعي.
ورغم أن كلمة الرئيسين في المؤتمر الصحفي لم تتطرق إلى أي من هذه التفاصيل الدفاعية، عدا إشارة أردوغان إلى التعاون المشترك لإنهاء سيطرة قوات “قسد” على شمال شرق سوريا، فإن ثمة ما يعزز ما نشرته رويترز.
ففي الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قام وفد عسكري من وزارة الدفاع التركية بأول زيارة من نوعها لدمشق، التقى فيها وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان، لمناقشة قضايا الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في أنقرة أنه:
“سيتم إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري، واتخاذ خطوات ملموسة بما يتوافق مع مطالب الحكومة السورية الجديدة”.
كل هذا يشير إلى جدية تركيا في سعيها لإعادة تأسيس الجيش السوري، إضافة إلى اضطلاعها بمهام أمنية داخل سوريا خلال هذه الفترة.
وأخيرًا:
إن هذه الفرصة الإستراتيجية التي أتيحت للدولتين، تعد الأعظم والأهم منذ انهيار الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان، وفي سبيل تعظيم الاستفادة منها، يجب عليهما التعاون معًا لمواجهة التهديدات التي ستعمل على إفشالهما معًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
الجيرة
——————————
طرطوس وأنا…بلا أب/ سالي علي
الجمعة 2025/02/07
طرطوس، مدينتي التي كانت يومًا ما رمزًا للهدوء، تحوّلت في الآونة الأخيرة مسرحاً للفوضى، بعد سقوط نظام بشار الأسد! هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في المشهد السياسي، بل بات غزو الخوف لكلّ بيت. خوفٌ من الأصوات، من الجدران التي قد تتكلم، من الطرق غير الآمنة، ومنَ المستقبل المُبهم.
أجدني غارقة في شعورٍ قديم، النقص الذي خلّفهُ غياب أبي. غيابٌ من النوع الأقسى، رجل حاضرُ بجسده، غائبٌ بروحه. أبي اختار أن يكون غائباً، أنانياً، بينما أمي تكفلت بحمايتنا وبناء حصننا النفسي. كنت أنظر إلى مكانه الشاغر وأتساءل: كيف يمكن له أن يكون غريبًا لهذه الدرجة؟ غيابه أضافَ المزيد من القلق إلى حياتي، وكأنّ كل شيء حولي يعيد صياغة درس أنّ الأمن الذي أبحث عنه لن يأتي إلا من داخلي. فقدان الأمان لم يكن طارئاُ، بل وُلد معي، حملت بداخلي خوفاً من الغرباء لا أجد له تفسيراً.
مازالت أمي حتى الآن عموداً في منزل تتلاعبُ به الرياح. أذكر كيف كانت تسهر معي الليالي بلا تذمر. عند الثالثة فجراً، عندما يهاجمني الجوع، تستيقظ بنصف عين وربع قدم، تكشفُ عن ثديها الجميل وتهدهدُ سريري كأنها تعلن انتصارها، تهمس للعالم بأن ابنتها جائعة، لتسقطَ كل الآلام و معها شهوة النوم، كي أرتاحَ أنا.
في أحد الأيام، انكسرت الكنبة بسبب ثقل أحد ضيوف والدي، وهو رجل ضخم وكثير النوم. كان يحتلُ منزلنا وكأنه فندق، نهاية كل أسبوع. وتلك الكنبة كانت أكثر من مجرد قطعة أثاث، الملاذ الذي تجد فيه أمي راحتها بعد جهد يوم طويل، وعندما تحطمت، كأن جزءاً من أمي تحطم معها.
لكن تحطم الكنبة لم يكن وحده ما أغضبني، بل وجود غرباء في منزلنا لا يجلبونَ سوى الفوضى والقلق! وأمي، التي أجبرت على استقبالهم لتتحمل صخب صالونٍ أدبي، فتستمع مضطرةً لترهات لا تنتهي. ورغم هذا، تعاملت بصبرٍ غير عادي، وابتلعت الإهانات المبطنة كونها لم تكمل تعليمها وتزوجت. تساءلتُ مراراً: كيف استطاعت احتمال هذا كله؟
لكن المفارقة أنها لم تكن مجرّد متفرجة صامتة. هذه المرأة الذكية قررت أن تواجههم، فدخلت نقاشاتهم في الدين والسياسة، الفن والأدب. كانت تطرح الأسئلة لتستفز أفكارهم، فتقلب معتقداتهم الموروثة رأساً على عقب فيما أراقبها بشغف، وكيف يصفقُ الجميع لانتصاراتها عليهم. ومن تلك الغرفة التي شهدت حروبَ الفكر، كان ذكاؤها شعلة أضاءت لي طريقي اليوم وأنا أكتب. كل كلمة أضعها على الورق هي امتداد لها. فهي الجسر الذي عبرتُه إلى العالم.
كبرتُ، وورثت موهبتها المخبأة التي حملَتها بين جدران المعتقلِ العائلي. وما زلت اليوم ألفُّ حول نفسي بحثاً عن الأمان، وأسأل نفسي باستمرار: هل سأجد مبرراً لغياب أبي؟ لعله أراد أن تنقلب الأدوار، فأصبح أنا المسؤولة، كأني أنا التي أنجبته! لكن مع مرور الوقت، لم أستطع الاحتفاظ بالمشاعر، فسقطت هويتي ومحبتي، سقطت صورته التي كانت معلقة على جدار قلبي. أنا الإبنة الثانية، التي استلقت في الشوارع تلعبُ “الغميضة” مع أبناء حارتها. لُقبت بالانتفاضة كوني كنت أجمع الحصى داخل علبة دخان “الشرق” لأرمي بها أي شخص يزعجني. كنت أبحث عن وسيلة للتعبير عن غضبي، عن جرحٍ لا يُشفى، من غياب الحماية التي من المفترض أن تمنحني إياها العائلة.
الدور الذي حملته أمي كان ثقيلاً. لذا، عندما نضجتُ، قررتُ أن أبحث عن أبٍ آخر! أردتُ شخصًا يمكن اللجوء إليه، يحل عقدتي، يجعل من شَربَكات الأفكار في رأسي شيئاً بسيطاً، ككنزةٍ دافئة تحميني من البرد النفسي. وبدأت البحث فعلاً، حتى أصبح الأمر مرهقاً، لكن جاء المنتظر الذي شعرت بسببه أني لست وحيدة، فلم أعد أخشى البرد.
كان رجلاً يتمتع بموهبة عظيمة، وهي الاستماع. أثار هذا الاهتمام بداخلي شعوراً عميقاً بالصدمة، حتى شككتُ في حقيقة وجوده! هل هو إنسان مثلي؟ أم جن؟ لكنه أثبت دائماً أنّه إنسان. بحتُ له بأغرب قصصي وحاولت تحليل نفسي معه، وساعدني في تحطيم أصنامي. كان يلملم التعب من حروفي، يهدهد ألمي، يعلمّني كيف أتنفس حينما يهاجمني الخوف. فأصبحتُ أعذرُ أبي أكثر، وفهمت أنه ربما لم تكن لديه القوة ليصبح أباً. لكني أيضاً عذرتُ نفسي واكتشفتُ كم امتلكتُ من صفات أمي، وكيف أن لحضور الأب البديل وحضورها، تأثيرٌ رائع أشبهُ بحركة جناح الفراشة التي تثير زلزالًا في مكان آخر.
لكن، بعد سقوط النظام، وتوالي الأحداث في مدينتي، عاد الخوف ومعه هواجس الحماية وغياب السكينة. أصبحت طرطوس تشبهني كثيراً، وبدأت أمي تستفسر عن كلفة باب حديدي لمنزلنا حتى تشتري لي الأمان… مرة أخرى.
المدن
———————————-
“هيئة تحرير الشام”… النشأة والتحولات الفكرية والعقيدة السياسية/ عباس شريفة
تفكيك الذات من أجل الدولة
08 فبراير 2025
كانت “هيئة تحرير الشام” التي أسسها أحمد الشرع والتي حملت اسم “جبهة النصرة”، فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الثورة السورية نهاية 2011، بمباركة وتوجيه من أبو بكر البغدادي، لكن بعد أن قويت شوكة “الجبهة” في سوريا بعد سلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد النظام مما أكسبها سمعة جيدة بين الناس، زاد عدد أتباعها ومؤيديها واستقطبت آلاف المقاتلين الأجانب إلى صفوفها.
هنا شعر تنظيم الدولة بتضخم الفرع على حساب الأصل ليأخذ قراره بدخول سوريا وإعلان تبعية “جبهة النصرة” للتنظيم وإلغاء العمل باسم “جبهة النصرة” ليضم كل مكتسباتها العسكرية والبشرية والمالية لتنظيم الدولة، لكن قيادة “النصرة” شعرت أن التبعية للفرع العراقي سيعيد التجربة العراقية المتخمة بالأخطاء والكوارث والانزلاق نحو الحرب الطائفية وسيذهب بكل مكتسبات الثورة التي تحققت في حال رضيت بالتبعية لـلتنظيم فقررت الهروب إلى الأمام وإعلان بيعتها لزعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري لتبدأ قصة الفراق الأبدي بينهما. وهكذا خطت “تحرير الشام” خطها السياسي المختلف والقائم على الحنكة والبرغماتية والواقعية ومراعاة الظروف الدولية والإقليمية وطبيعة المجتمع المحلي في سوريا مع احتفاظها بمرجعيتها الإسلامية.
وفي هذا المقال سنناقش مراحل التطور الفكري لـ”هيئة تحرير الشام” وعقيدتها السياسية والعسكرية والعقلية الاستراتيجية لقيادتها المتمثلة في القائد أحمد الشرع لنتعرف على هذه الجماعة الأكثر تنظيما وانضباطا والتي استطاعت مع حلفائها في إدارة العلميات العسكرية أن تسقط الأسد بمعركة استمرت 11 يوما في ظرف دولي وإقليمي كان غاية في التعقيد.
أولا: مراحل التحول من النشأة إلى “هيئة تحرير الشام”
بدأت مسيرة التحولات لدى “هيئة تحرير الشام” التي انتهت بتحولات كثيرة منذ أن ظهرت باسم “جبهة النصرة” نهاية 2011 إلى اليوم ولعلنا هنا نسرد أهم هذه المراحل والتحولات.
المرحلة الأولى والتحول في اكتساب المشروعية الجهادية
بدأت هذه المرحلة في 10/4/2013 حين أعلن أحمد الشرع قائد “جبهة النصرة” المعروف وقتها بـ”أبو محمد الجولاني” عن بيعته لتنظيم “قاعدة الجهاد” وزعيمها أيمن الظواهري وفك ارتباطه من تنظيم “داعش” الذي أعلنه أبو بكر البغدادي في اليوم نفسه، وهاهنا تحول تنظيم “جبهة النصرة” من فرع لمشروع “داعش” إلى فرع لتنظيم “القاعدة”، وتحولت “جبهة النصرة” إلى الفرع السوري لتنظيم “القاعدة” الذي كانت علاقتها به شكلية بسبب ضعف الاتصال وضعف التنظيم بشكل عام. ورغم هذه التبعية الشكلية، لم يقم أحمد الشرع بأي نشاط خارج الحدود السورية ولم تكن التبعية لـ”القاعدة” إلا إجراء فرضته الإكراهات السياسية لقطع الطريق على تنظيم الدولة ومنعه من التوغل في سوريا. ومن أجل حماية القوة التي بناها أحمد الشرع تحت مظلة جهادية مختلفة عن تنظيم “داعش”، لم يكن الشرع يهتم بالتبعية لـ”القاعدة” أو تنظيم “الدولة” أكثر من اهتمامه بالاستقلال عنهما والبحث عن مساحته الخاصة للعمل العسكري دون أي وصاية صارمة عليه وهو ما يفسر انفكاكه عن تنظيم “القاعدة” عندما حاولت قيادتها الانتقال إلى سوريا والسيطرة على قيادة الفرع السوري للتنظيم.
المرحلة الثانية والتحول التنظيمي
أدت الظروف الصعبة التي واجهتها “جبهة النصرة” من فشل معركة تحرير حلب التي شنها “جيش الفتح” وهو مجموعة من الفصائل المتحالفة بداية شهر أغسطس/آب 2016 بسبب الخلافات الفصائلية ومحاولة تنظيم “القاعدة” السيطرة على قيادة الفرع السوري “جبهة النصرة” إلى تحرك الشرع وطرح مشروع جديد يبدد مخاوف الفصائل من تبعية “جبهة النصرة” لتنظيم “القاعدة” ليكون مقدمة لدعوة الفصائل الأخرى للتوحد معه في مشروع جامع، فذهب الشرع إلى تأسيس جبهة “فتح الشام” في تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2014 والتي أنهى في بيان تأسيسها ارتباطه بتنظيم “القاعدة” وإنهاء التبعية لها وإضفاء الصفة القطرية والمحلية على التشكيل الجديد “فتح الشام” والقطع مع تنظيم “القاعدة” العابر للحدود، مع التمسك بوحدة الانتماء والمدرسة والأدبيات والاعتراف لهم بالفضل وهو الأمر الذي رفضه الظواهري محاولا إعادة إحياء التنظيم عبر تأسيس تنظيم “حراس الدين” في شهر فبراير/شباط 2018 والذي عمل الشرع على تفكيكه تماما فيما بعد.
المرحلة الثالثة والتحول الأيديولوجي
بدأت هذه المرحلة مع تأسيس الشرع لـ”تحرير الشام” في 28 يوليو/تموز 2016 وهو تشكيل ضم عددا من الفصائل مثل “حركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار وحركة الفجر ولواء الحق”.
وبذلك أنهت “تحرير الشام” تبعيتها الفكرية للسلفية الجهادية ولم تعد شخصيات مثل المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني يشكلان أي تأثير شرعي في توجهاتها وقراراتها وفي هذه الفترة بدأت “هيئة تحرير الشام” تغيير خطابها الشرعي، قاطعة بذلك مع نهج “القاعدة” و”السلفية الجهادية”، متجهة إلى الحديث عن مرجعية المذاهب الأربعة الفقهية وليس مقررات اتجاه بعينه والاعتماد على العناصر السورية في المواقع القيادية والشرعية المتقدمة.
المرحلة الرابعة والتحول السياسي
بدأت هذه المرحلة تبدو ملامحها مع تشكيل “هيئة تحرير الشام” لحكومة الإنقاذ في شمال غربي سوريا، بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. مستعينة بشخصيات تكنوقراط مستقلة من خارج تنظيم “هيئة تحرير الشام” لتقديم الخدمات في منطقة شمال غربي سوريا كما عملت في حينها على استقطاب أكبر عدد ممكن من الناشطين والإعلاميين الذين يحظون بقبول شعبي بين الناس، كما وافقت على إدخال نقاط المراقبة التركية إلى مناطق سيطرتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وأرست الإدارة السياسية برئاسة أسعد الشيباني وهو ما فتح المجال لعلاقات راسخة بين تركيا و”تحرير الشام” ومع الكثير من الدول التي بدأت تتواصل معها.
ثانيا: العقيدة السياسية والعسكرية
في الوثائقي الأميركي الذي حمل اسم “الجهادي”، الذي أنتجه الإعلامي الأميركي مارتن سميث بداية شهر يونيو/حزيران 2021 اعتبر أحمد الشرع فيه أن نهج تنظيم “القاعدة” نهج خاطئ ومنحرف وأن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2000 جريمة مرفوضة، وتنظيم “داعش” تنظيم محظور في مناطق سيطرة “تحرير الشام” بمنطقة شمال غربي سوريا و”هيئة تحرير الشام” هي من تقوم بقتاله في إدلب اليوم كما اعتبر وضع “هيئة تحرير الشام” على قوائم الإرهاب مجرد تصنيف سياسي وحكم جائر وعلى الغرب إعادة النظر فيه وأن السعي في إزالته واجب شرعي، كما تحدث أحمد الشرع عن المصالح المشتركة والمهمة مع الولايات المتحدة والغرب ورحب الشرع بالصحافيين الأجانب في ربوع إدلب لينقلوا الحقيقة إلى العالم وتعهد بحمايتهم مع كفالة حريتهم، ودعا المنظمات الإغاثية الغربية لمساعدة الشعب السوري الذي يعاني الشدة والفقر واعتبر تركيا دولة حليفة وصديقة وتعهد بمواجهة أي مقاتل أجنبي يمسها بسوء.
كما أعاد الشرع تعريف ما يجري في سوريا بأنه ثورة شعبية ضد نظام سفاح مجرم وليس تجربة جهادية، وبات علم الثورة هو العلم المرفوع في مظاهرات إدلب بعد منعه لسنوات، وقد ظهر الشرع بدرجة كبيرة من الشفافية ليفصح عن اسمه وعن أحوال عائلته بالتفاصيل كما تحدث عن حقوق الأقليات والطوائف المكفولة بنص الشريعة، وأكد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار مع النظام الذي أبرم بين روسيا وتركيا في شهر مارس/آذار 2020.
وبالنسبة للعقيدة العسكرية فرغم تبعية “جبهة النصرة” سابقا، “هيئة تحرير الشام” حاليا، لتنظيم “القاعدة” في مرحلة من المراحل، فإن الهيئة لم تقم بأي نشاط عسكري أو أمني خارج الحدود السورية وعندما فك أحمد الشرع بيعته لـ”القاعدة” عام 2016 كان يؤكد تعريف العقيدة القتالية لـ”تحرير الشام” بأنها حركة تحرر وطني محلية رغم وجود عناصر أجنبية في صفوفها لا يتجاوز عددهم 5 آلاف مقاتل من أصل 18 ألف مقاتل سوري محلي من جنود “هيئة تحرير الشام” والقسم الأكبر من هؤلاء المقاتلين هم من قومية الإيغور والباقي من مختلف الدول العربية والإسلامية بعدد قليل جدا.
كما أن منهجها الفكري بات يستند إلى فهم معتدل للإسلام ينفتح على كل المدراس الفقهية ولا ينحصر في منهج “السلفية الجهادية”.
ثالثا: الرؤية الاستراتيجية لقيادة “هيئة تحرير الشام”
لا تستند الرؤية السياسية لأحمد الشرع على الأيديولوجيا أو الوصفات النظرية الجاهزة مع أنه كثير القراءة، إنه رجل يحسن التخطيط ويمتلك قدرة فائقة على الصبر الاستراتيجي ولا يدخل في مغامرات عسكرية غير محسوبة أبدا، كما أنه يرصد الفرصة بشكل جيد ويقتنصها في الوقت المناسب ويرى أن الاعتراف السياسي ليس مجرد استحقاق قانوني رسمي وإنما أقدام ثقيلة على الأرض تجعل منك رقما صعبا، ومع تقاطع المصالح الحيوية للدول معك سترغم الأطراف الدولية والإقليمية على التعامل معك والاعتراف بك كفاعل أساسي.
لقد حول الشرع تحدي الضيق الجغرافي في إدلب وانعدام الموارد مع اكتظاظ المنطقة بالسكان والمخيمات إلى فرصة فقد كان النظام يظن أنه طرد كل معارضيه إلى إدلب وأنه تخلص منهم إلى الأبد وأن طول انتظارهم في إدلب سيدفعهم لفقد الأمل والرضوخ للاستسلام أو الهجرة إلى أوروبا.
لقد كان سكان إدلب من السكان الأصليين ومن المهجرين من كل المحافظات السورية يربو عددهم على 4 ملايين نسمة، مليون منهم يسكنون الخيام.
لقد استطاع الشرع أن يستثمر في هذه الموارد البشرية ففتح الجامعات في إدلب والتي بلغ عدد طلابها 18 ألف طالب من الذكور والإناث وكثير منهم كانوا من عناصر “تحرير الشام” وأقام منظومة اقتصادية عملت على تنمية المنطقة بحيث أصبحت الخدمات في إدلب أفضل منها في دمشق رغم انعدام الموارد وعلى الجانب العسكري أقام الشرع معسكرات التدريب وأسس الأكاديمية العسكرية ووسع دائرة تحالفاته مع فصائل المعارضة وأسس 17 لواء مقاتلا مجهزا بالعدة القتالية الكاملة ودعم التصنيع العسكري المحلي الذي أنتج الطائرات المسيرة شاهين المصنعة محليا.
كما أنشأ جهازا أمنيا قويا استطاع أن يقاوم كل محاولات الاختراق والتفكيك من داخل تنظيمه وطوق كل حركات التمرد التي حاولت الانقلاب عليه. ورغم كل هذه النجاحات العسكرية والاقتصادية والخدمية والأمنية كان سؤال التحرير والمعركة مع النظام هو السؤال المطروح دائما، خصوصا من المهجرين الذين أخرجهم النظام من مدنهم وقراهم.
وهنا جاءت الحرب الأوكرانية الروسية في بداية شهر فبراير 2022 لتطرح سؤالا إلى أي مدى يمكن أن تنكفئ روسيا على نفسها إذا استنزفت في هذه الحرب ثم جاءت حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليطرح سؤلا آخر وهو إلى أي مدى يمكن أن تتدحرج الحرب وتفقد إيران أذرعها في سوريا ولبنان.
لقد بنى الشرع قراره على هذه المعطيات وبدأ فعلا بالتجهيز للمعركة وأخذ قرار الحرب بعد أن امتدت الحرب الإسرائيلية إلى لبنان. لكنه من وازع الموقف الأخلاقي لم يعلن عن بدأ المعركة إلا بعد أن وقع “حزب الله” اتفاقا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في 26 نوفمبر 2024، وكان قرار الحرب في يوم 27 نوفمبر 2024 وفي غضون 11 يوما وفي يوم 8 ديسمبر كانت قوات إدارة العمليات العسكرية تجوب شوارع دمشق معلنة سقوط نظام الأسد.
التحول إلى فكر الدولة
بعد أن أدت “هيئة تحرير الشام” مهمتها في إسقاط نظام الأسد وبعد وصولها إلى دمشق ودخول الشرع إلى قصر الشعب والسيطرة على القسم الأكبر من التراب السوري وعلى مؤسسات الدولة، باتت الجماعة أمام التحدي والاستحقاق الأهم وهو مدى إمكانية التحول من التنظيم إلى الدولة؟ وما هي إمكانية الانفتاح على كل المكونات والشرائح السورية وتحقيق الانتقال السياسي لدولة مدنية تعددية ديمقراطية بشراكة وملكية سورية. من الواضح أن قيادة “تحرير الشام” تدرك استحقاقات المرحلة ولديها الرغبة والقدرة على تحقيق هذا التحول وهي في سباق مع الزمن في هذا الأمر.
كما أن التحولات والقرارات الجريئة والتي كانت غير متوقعة التي اتخذتها الجماعة في مسيرتها خلال 13 سنة ماضية يدفعنا للتفاؤل بأن الجماعة ماضية في تفكيك نفسها لصالح بناء الدولة السورية ومؤسساتها وأن قدرتها على ضبط سلوك المقاتلين الأجانب طوال السنوات السابقة يحمل الكثير على الثقة بالشرع في إدارة هذا الملف.
المجلة
———————————
هل انتهى زمن الإيديولوجيا والأحزاب العقائدية؟/ د. فيصل القاسم
تحديث 08 شباط 2025
لا نبالغ إذا قلنا إن السياسة والأحزاب العقائدية قد بدأت تختفي من الساحة السياسية، وخاصة في الغرب منذ القرن الخامس عشر وما بعده، عندما بدأ المجتمع الزراعي يتلاشى، ليحل محله العصر الصناعي، حيث حدث الانقلاب الفعلي على الكنيسة ورجال الدين ليبرز مكانهم طبقة جديدة من رجال الأعمال والصناعيين الذين لم يكن همهم وقتها فقط القضاء على الحكم الديني فحسب بل أيضاً التحضير للمرحلة الاستعمارية الغربية، حيث بدأت الطبقة الجديدة من السياسيين تفكر بعلمنة الحياة سياسياً واجتماعياً تمهيداً لتغيير المجتمعات في الداخل وإطلاق الحملات الاستعمارية إلى أفريقيا وغيرها. بعبارة أخرى، يمكن القول إنه منذ ذلك الحين بدأ القضاء على الفكر السياسي الديني وإبعاده عن الساحة، وذلك بفصل الدين عن الدولة، لا بل قفزت أبعد من ذلك ليكون اهتمامها الأساسي والرئيسي منصباً على القضايا المادية بالدرجة الأولى.
وكلما تطورت الحياة السياسية المادية، كنا نرى ظهور العديد من الأعمال الأدبية من روايات ومسرحيات وخاصة في الأدب البريطاني، وكلها كانت تنتقد وتفضح الجنوح الجنوني في اتجاه المادة والتخلي عن الجوانب الروحية والإنسانية للإنسان. وقد شاهدنا ذلك في روايات أرنولد بَنيت، ودي أتش لورانس، وجين أوستين، وتشارلز ديكنز، وغيرهم. ولا شك أن الاتجاه المادي في الحياة والسياسة الغربية قد أصبح فاقعاً جداً خلال القرن العشرين وما تلاه، وذلك بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجي المذهل، بحيث بات الناس في الشرق والغرب مهووسين بالمال والتكنولوجيا، وبدأوا يبتعدون أكثر فأكثر عن الحياة الروحية، فالكل اليوم يريد أن يقتني أحدث المنتوجات التكنولوجية من موبايلات وسيارات وتلفزيونات وألعاب وآلات وأدوات لا يمكن للشعوب أن تعيش من دونها، وبالتالي فإن العقل السياسي لا بد أن يساير هذا التحول التكنولوجي الرهيب ويجاريه سياسياً، خاصة إذا ما علمنا أن الواقع الاقتصادي، كما قال كارل ماركس، هو الذي يحدد ويرسم الواقع الاجتماعي، فالاقتصاد والمال هما اللذان يقودان السياسة والمجتمع وليس العكس، وهذا يعني أن السياسة تحولت منذ زمن طويل، وخاصة في البلدان المتقدمة، من سياسة عقائدية إلى سياسة اقتصادية وبالضرورة برامجية ووظيفية، وقد شاهدنا كيف سقطت الأنظمة ذات التوجه العقائدي في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية الشرقية عموماً، لأنها بالغت في التركيز على العقيدة السياسية بعيداً عن الواقع الاقتصادي والتكنولوجي المتحول بسرعة رهيبة، لهذا مثلاً كنا نرى كيف كان الشعب السوفياتي يتوق لتدخين سيجارة مالبورو أمريكية، أو تناول وجبة ماكدونالد، لأنه كان غارقاً في عالم عقائدي أجوف، سقط كله أخيراً وتوجه في اتجاه الاقتصاد والسياسة الحزبية البرامجية التي تقوم على وضع برامج اقتصادية وتنموية لخدمة المجتمعات بدل الغرق في خزعبلات الأيديولوجيا.
قد يقول قائل: ألا ترى أن المجتمع الأمريكي مثلاً مازال يشارك في الانتخابات على أساس عقائدي؟ ألم يفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة بأصوات المعارضين للتحول الجنسي والمثلية؟ لا شك أن شرائح كثيرة من كل الأديان في أمريكا صوتت لترامب لأنه يعارض التحول الجنسي، لكن الذين صوتوا له لم يصوتوا على أساس ديني، بل على أساس اجتماعي، لأن ظاهرة التحول الجنسي باتت تشكل خطراً على المجتمع وحتى على الاقتصاد، وبالتالي فالتصويت لترامب لم يكن على أساس عقائدي محض.
ولو نظرنا اليوم الى الأحزاب المتنافسة في الغرب لوجدنا أن الفروقات العقائدية والأيديولوجية بينها قد بدأت تختفي تدريجياً إن لم تكن قد اختفت تماماً في بعض البلدان، لأن الشعوب باتت تريد أحزاباً برامجية ووظيفية وخدمية أكثر منها عقائدية. الشعوب، وخاصة العربية المسحوقة، تريد اليوم تنمية وخدمات وتطوراً ووضعاً معيشياً مقبولاً، ولم تعد تذهب الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلها الروحي. ولو سألت الناخبين في بريطانيا أو أي بلد أوروبي آخر مثلاً ستجد أنهم أدلوا بأصواتهم لصالح هذا الحزب أو ذاك لأنه يقدم خدمات أكثر من غيره، وليس بناء على توجهاته العقدية. ولو قارنت بين حزبي العمال والمحافظين اليوم في بريطانيا ستجد أن خلافاتهما العقائدية قد خفت كثيراً، وصار التنافس على البرامج والتنمية والخدمات أكثر منه على العقيدة السياسية. فإذا كان الوضع هكذا في الغرب المتقدم علينا بأشواط في موضوع الخدمات والتنمية والتطور، فكيف إذاً بمجتمعاتنا العربية المحرومة من أبسط الخدمات؟ الشعوب العربية اليوم تريد تنمية وتطوراً وتحسين أوضاعها المعيشية المزرية، والأحزاب التي تريد أن تنجح في إدارة أي بلد عربي اليوم يجب أن يركز بالدرجة الأولى على برامجها التنموية، فقد فشلت كل الأحزاب العقائدية على الصعيد التنموي، وتحولت إلى عصابات. وقد شاهدنا السقوط المدوي لما يسمى بنظام البعث في سوريا ونظام الإنقاذ في السودان. التنمية ثم التنمية إذاً أولاً وأخيراً. وطوبى للتنمويين الجدد!
كاتب واعلامي سوري
القدس العربي
—————————-
حوار وزير الدفاع السوري مع “واشنطن بوست”…رسائل استراتيجية للغرب؟/ مصطفى الدباس
السبت 2025/02/08
لم تكن تصريحات وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، مجرد مقابلة اعتيادية، بل حملت رسائل استراتيجية تعكس محاولة الحكومة السورية الجديدة إعادة رسم موقعها في النظام الدولي، بعيداً من إرث النظام السابق.
وجاء اختيار وسيلة إعلام أميركية كمنصة لهذه التصريحات، في توقيت حساس، كإشارة واضحة إلى أن دمشق تسعى إلى كسر عزلتها عبر التواصل المباشر مع الغرب، مستخدمة خطاباً أكثر براغماتية وأقل تصادماً.
لكن نجاح هذا التوجه يبقى مرهوناً بقدرة دمشق على تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتضاربة للقوى الفاعلة في المشهد السوري، وعلى رأسها روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، والتي رغم اختلاف أجنداتها، تتقاطع عند نقطة واحدة: عدم السماح لسوريا بالخروج تماماً من دائرة نفوذها، ما يجعل المناورة السياسية للحكومة السورية الجديدة معقدة ومحدودة الخيارات.
وتكشف تصريحات أبو قصرة تحولات جوهرية في السياسة الخارجية السورية، حيث اختفى الخطاب العدائي التقليدي تجاه الولايات المتحدة وتركيا، وحل محله نهج قائم على التفاوض وإعادة التموضع، ويطرح ضمن إطار “إعادة التفاوض” و”إعادة التوزيع”. وهي إشارات دبلوماسية تعكس إدراكاً لتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وسعي دمشق إلى تحقيق مكاسب عبر الحوار بدلاً من التصعيد غير المحسوب الذي كان يقوم به النظام السابق بشكل اعتباطي.
وتبدو دمشق مدركة لحقيقة أن مُطالبة الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا أمر غير واقعي في المرحلة الحالية، ولذلك بات الخطاب السوري أكثر حذراً، مع التركيز على أن الوجود الأميركي “قيد التفاوض”، بدلاً من تصنيفه كاحتلال تجب مقاومته. هذا التحول لا يعني بالضرورة قبول الوجود الأميركي، لكنه يعكس محاولة لاستكشاف فرص تفاوضية، خصوصاً ما يتعلق بملف قوات سوريا الديموقراطية “قسد”.
على المستوى الاستراتيجي، تراهن دمشق على أن واشنطن التي تعيد ترتيب أولوياتها في الشرق الأوسط، وربما تكون أكثر استعداداً لتخفيف انخراطها العسكري في سوريا إذا ضمنت ترتيبات تحفظ مصالحها، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة تنظيم “داعش” ومنع تمدد النفوذ الإيراني.
من هنا، يبدو أن التقليل من نبرة العداء تجاه الولايات المتحدة هو جزء من استراتيجية تهدف إلى فتح قنوات خلفية للحوار، حتى لو لم يكن ذلك معلناً في الوقت الراهن، وربما تكون فاتحة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، التي تعتبر عقبة في وجه إعادة الإعمار.
المثير للاهتمام هنا هو تصريح أبو قصرة بشأن بقاء القواعد العسكرية الروسية “بما يخدم المصالح السورية”. هذه الصياغة تحمل أبعاداً مزدوجة، فمن جهة تسعى الحكومة الجديدة إلى إظهار استقلالية نسبية في علاقتها بموسكو، ومن جهة أخرى تحاول الإيحاء بأن استمرار الوجود الروسي ليس أمراً مسلّماً به، بل يجب أن يكون مشروطاً بترتيبات تحقق فائدة متبادلة.
هذا الطرح يواجه تحدياً واقعيأً، فموسكو ليست مجرد حليف عسكري، بل تمتلك نفوذاً راسخًا داخل الدولة السورية منذ أيام الاتحاد السوفياتي، ومن غير المرجح أن تقبل بأي تراجع لدورها، خصوصاً بعد استثمارها العسكري والاقتصادي الضخم منذ 2015. ولذلك، فإن أي محاولة سورية للتمايز عن الموقف الروسي يجب أن تتم بحذر شديد، كي لا تؤدي إلى ضغوط قد تعرقل هذا التوجه.
في الوقت ذاته، يمكن قراءة هذه الإشارة إلى “إعادة التفاوض” بشأن القواعد الروسية كمحاولة لاختبار رد فعل الولايات المتحدة، التي ترى في التمدد الروسي في سوريا تهديداً لمصالحها الإقليمية.ربما تلمح دمشق هنا إلى استعدادها لتقديم تنازلات في هذا الملف مقابل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية مع الغرب، وهو نهج يعكس محاولة لإيجاد هامش للمناورة بين واشنطن وموسكو من دون الانحياز المطلق لأي طرف.
وتدرك دمشق أن أي تقارب مع تركيا يجب أن يأخذ في الاعتبار هواجس أنقرة الأمنية، خصوصاً ما يرتبط بمنع قيام كيان كردي مستقل على حدودها. بالمقابل، فإن هذا التقارب قد يضع سوريا في مواجهة مع إيران، التي ترى في أي انفتاح سوري تركي تهديداً لنفوذها الإقليمي، تحديداً في المناطق الحدودية التي تشكل جزءاً من ممرها الاستراتيجي الممتد من العراق إلى لبنان.
بالتالي، فإن تحقيق توازن في العلاقة بين أنقرة وطهران سيكون اختباراً حقيقياً للمهارات الدبلوماسية للقيادة السورية الجديدة.
في المجمل، تسعى الحكومة السورية إلى إعادة تموضعها كلاعب مستقل، لكنها ما زالت مقيدة بتوازنات القوى الإقليمية والدولية، ونجاحها في تحقيق هذا الهدف يعتمد على قدرتها على إدارة العلاقات مع موسكو وطهران من دون الدخول في صدام مباشر، وفي الوقت ذاته التفاوض مع أنقرة وواشنطن من دون تقديم تنازلات قد تؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة من حلفائها التقليديين.
إذا استطاعت دمشق المناورة بذكاء في هذه المساحة الضيقة، ربما تتمكن من إعادة صياغة موقعها في المشهد الدولي، لكن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التبعية لمحور معين، ما قد يحد من قدرتها على بناء سياسة خارجية متوازنة. والأسابيع المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القيادة السورية الجديدة على تحويل هذا الخطاب الدبلوماسي إلى واقع سياسي عملي، وسط شبكة معقدة من المصالح المتشابكة التي سترسم ملامح سوريا في المرحلة الجديدة.
المدن
———————————
أبو محمد الشرع: بورتريه ساخر/ عبد الدافش نكاشة
08.02.2025
يكتب عبد الدافش نكاشة بعد تأملات في سيرة “أبو محمد الشرع” بورترية يفصل فيه تحولات الجولاني، الحوراني ابن المزة، وبراغماتيته التي تصل حد قول كلمات بالانجلش.
أحمد الجولاني، سكّر أممي محطوط على كريما محلية، ساحر بلا قبعة، يُسمع السوريين حين يقابلهم كلمات ليست كالكلمات، بعضها بالإنجلش. فارس على صهوة سيارة مفخخة، طريقه سالك: شنّ هجوماً على حلب فوجد نفسه في قصر الشعب. زعيم المماليك بلا مذبحة القلعة.
لا يصافح، ولو قلّدوه القيادة. رئيس بلا انتخابات وبلا توريث، زعيم الجمهورية الثالثة الحالم بالأبدية الثانية. مريّح رأسه: لا يعد ولا يفي ولا ينكث. خاطب الشعب بعد لأي وخطب ودّه، ليس كلّه بالطبع. أمره شورى بينه وبين نفسه، الديمقراطية ليست من مفرداته، تعدديته الأثيرة هي ربطات عنقه الملونة، بحسب الزائر والزيارة.
أمير القلوب، أبو تريكة بلا استوديو تحليل. الإعلاميون أسهم في كنانته، الخشية أن يتحولوا إلى قذائف توجيه معنوي وبراميل بروباغندا مع الوقت.
جولاني في إدلب، شامي في دمشق، زرقاوي في العراق، عربي في القامشلي، جندي حفظ سلام بعمامة زرقاء في القنيطرة، يفهم التعقيدات المحلية كمقاتل أوزبكي مع “هيئة تحرير الشام”.
كلمته رقيقة، صوته دافئ، كرباجه غليظ، سجونه متينة. عادل كشادي الويسي، صارم كأبي أحمد حدود، جذاب كأسعد الشيباني، ماهر كشقيقه ماهر.
سلّم أبو بكر البغدادي لواشنطن، قهر بشار الأسد في دمشق، تحالف مع أبو عمشة في حلب، جمعه بأبي ماريّا القحطاني حبٌّ قاتل، علاقته مع رجب طيب أردوغان “إز كومبليكايتد”.
ثعلب الدبلوماسية، وزير خارجية فايت، سفير طالع. مضياف، استقبل وفوداً من أربع جهات الأرض، ماطل قبْل استقبال أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً، الحاجّة أم أوستن تايس استثناء، فالأمريكنجي برنجي.
مثال عملي على صحّة نظرية التطور: الإنسان في عشرينياته غير الإنسان في ثلاثينياته غير الإنسان في أربعينياته. مع ذلك، كلما طالت الإقامة في القصر قصرت اللحية. أما ماضيه، فهو طيش شباب لا أكثر.
تمنى سابقاً أن يعفيه السوريون من منصب الرئاسة كي يرتاح، لكن يبدو أن المسكين سيتعب معهم طويلاً… طويلاً.
درج
———————————
وفجأة هرب الأسد… العلوم السياسية وتمييع السياسة!/ زياد عدوان
08.02.2025
قد يكون السؤال عما تقوم به العلوم السياسية والخبراء والمحللون السياسيون سورياً بالقدر الذي يتّخذ منحى عالمياً أيضاً. وكانت الاحتجاجات التي ألمّت بالعالم في العشرية الثانية من القرن الحالي كالربيع العربي، والسترات الصفر في فرنسا، والمزارعين على التراكتورات في ألمانيا، واحتلال وول ستريت في الولايات المتحدة، أمثلة على فشل السياسة في توقّع حدوث هذه الاحتجاجات، وفقدان ثقة العديد من الشرائح الاجتماعية بالتمثيلات السياسية في هذه الدول.
كان هروب بشار الأسد مفاجئاً، كما كان مفاجئاً اندلاع الاحتجاجات عام 2011. وبالمثل، كان ظهور “داعش” مفاجأة أخرى، و”طوفان الأقصى” مفاجأة. ولكن المفاجأة الحقيقية هي أن الجميع كان متفاجئاً، على الرغم من امتلاء الفضائيات بالمحللين السياسيين والخبراء العسكريين، وتزايد مراكز الأبحاث السياسية والجيوسياسية، لم تستطع هذه الخبرات السياسية أن تتوقّع سيناريو هروب بشار الأسد، كما كان الحال عندما لم تتوقّع هذه الخبرات العديد من الأحداث المفصلية التي ألمّت بسوريا والمنطقة.
تستدعي هذه المفاجآت أسئلة عن المرجعيات والمناهج التي يستند إليها علماء السياسة وأكاديميوها، عند تقديم رؤاهم وأطروحاتهم التي لم تمتلك الرؤى لتوقّع ما سيحدث، أو لرسم استراتيجيات مستقبلية.
ما الذي يقوم به الخبراء السياسيون حقيقة؟ ولِمَ هم قاصرون عن تقديم رؤى تتطابق مع ما سيحدث؟ وما أسباب القصور عن إضافة معرفة ما بعيدة عما يدركه العامة من أقاويل تردّد أن الإيرانيين والروس قد سئموا الأسد، وأن جيشه بات ضعيفاً بسبب الفساد وانعدام الثقة، وأن العرب تخلّوا عنه بسبب كذبه وإصراره على تهريب الكبتاغون، وأن قوى خفية ومسيطرة حسمت هذا المصير المفاجئ؟
كلما تحدث الساسة وخبراء السياسة عن الحل السياسي، استعرت الحرب
اعتاد المحللون والأكاديميون السياسيون، سواء عبر الشاشات أو من خلال المراكز البحثية والأكاديمية، على تكرار ما يراه ويستنتجه الجميع من نشرات الأخبار والمقالات والسوشيال ميديا.
وللمفارقة تردّدت عبارات طوال الأربع عشرة سنة الماضية، مشيرة إلى أن الحل في سوريا هو حل سياسي، وكلما تحدّث الساسة وخبراء السياسة عن الحل السياسي، استعرت الحرب، وكأن الحديث عن عبارات الحل السياسي كان لتمييع المسألة السورية، ريثما تأخذ الحلول العسكرية والاستخباراتية ومعاملات الفساد والصفقات وتبادل المعلومات الأمنية مجراها، وظلت كلمة الحل السياسي هي السائدة إلى أن هرب بشار الأسد بمزيج من حل عسكري وأمني.
قد يكون السؤال عما تقوم به العلوم السياسية والخبراء والمحللون السياسيون سورياً بالقدر الذي يتّخذ منحى عالمياً أيضاً. وكانت الاحتجاجات التي ألمّت بالعالم في العشرية الثانية من القرن الحالي كالربيع العربي، والسترات الصفر في فرنسا، والمزارعين على التراكتورات في ألمانيا، واحتلال وول ستريت في الولايات المتحدة، أمثلة على فشل السياسة في توقّع حدوث هذه الاحتجاجات، ومن ثم التعامل معها وقراءة تنظيماتها وأهدافها ومرجعياتها. كما أكّدت هذه الاحتجاجات الهوة بين السياسيين والمواطنين، وفقدان ثقة العديد من الشرائح الاجتماعية بالتمثيلات السياسية في هذه الدول.
ما الذي يقوم به الخبراء السياسيون حقيقة؟ ولم هم قاصرون عن تقديم رؤى تتطابق مع ما سيحدث؟
ولعل أحد أكبر مفاجآت القرن الواحد والعشرين كانت الأزمة الاقتصادية التي حصلت في عام 2008. أثبتت هذه الأزمة طواعية الساسة أمام عوالم البنوك ودورات رأس المال، لتُنقذ البنوك عبر إجراءات لم تكن مفهومة من قِبل عموم البشر الذين تضرروا فعلياً من هذه الأزمة.
تعافت البنوك من “الأزمة” المالية بإنقاذ “سياسي”، ولكن كانت تلك المفاجأة صدمة للبشر الذين هجروا بيوتهم، كما كانت صدمة بالنسبة للسياسيين وحيتان المال. لماذا فشلت الخبرات السياسية في توقّع هذا الانهيار؟ وكيف فشلت في توصيف “فقاعة” المعاملات البنكية وقروض السكن على حد تعبير الفيلم الأميركي (The Big Short)؟
اتّسم القرن الواحد والعشرون بتغييرات تكنولوجية واجتماعية هائلة، ولكن ظلت العلوم السياسية بمناهجها قاصرة عن توصيف ما يحدث، وعلى حد تعبير سلافوي جيجيك ينحو السياسيون إلى استخدام مفردات من القرن العشرين، لتفسير الانعطافات السياسية الكبيرة التي يشهدها هذا القرن. حتى كلمة ثورة، بنظر جيجك، هي استعادة نوستاليجية لمفردة كانت لها رنتها في القرن العشرين، ولكن قد لا تكون المفردة صالحة لتوصيف الربيع العربي، أو احتلال وول ستريت، أو السترات الصفر، أو حتى Me-Too.
في كتاب “التقشّف: تاريخ فكرة خطيرة”، يروي مارك بليث كيف فشل السياسيون في توقّع الأزمة الاقتصادية في عام 2008، كما فشلوا في سياسات التقشّف التي قاموا بها عبر رعونة مرجعياتها العملية والنظرية، وينسجم هذا النقد مع افتقار الأكاديمية السياسية التقليدية للأدوات التي تتعامل مع كوارث عصرنا كمشكلة البيئة والإرهاب العالمي والإحباط الاقتصادي.
وفي معرض قراءته للربيع العربي، يشير بليث إلى الأنظمة العربية المعقدة التي اضطهدت التقلّبات بطرق سطحية ومصطنعة، وبرغم هشاشتها الشديدة كانت على الدوام تشير إلى أنها غير معرّضة للخطر.
تقع هذه الأحداث الكارثية خارج نطاق التوقعات المعتادة، وغالبًا ما يتم تبريرها من قبل خبراء السياسة بعد وقوعها.
نظرية البجعة السوداء التي وضعها نسيم نيكولاس طالب، هي إشارة إلى الأحداث غير المتوقّعة التي تُلقي أثراً هائلاً على العالم وتؤدي إلى انعطافات تاريخية. تقع هذه الأحداث الكارثية خارج نطاق التوقّعات المعتادة، وغالباً ما يتم تبريرها من قبل خبراء السياسة بعد وقوعها.
كتب نسيم طالب مع مارك بليث مقالة بعنوان “البجعة السوداء في القاهرة: كيف يجعل قمع التقلّبات العالم أقل قابلية للتنبؤ وأكثر خطورة”، ناقش الكاتبان الكيفيات التي يُوهم بها السياسيون وخبراء السياسة الجميع بالاستقرار وامتلاك اليقين، بينما يؤدي هذا الشعور الزائف بالاستقرار إلى نهايات كارثية، وإحساس عام بعدم الشعور بالاستقرار.
وفي الوقت الذي يقوم به السياسيون في أوروبا والشمال الأميركي بالتلاعب بالألفاظ لحماية تراكم الثروة بيد الفئات القليلة، ولصون التبعية والطاعة، وتدمير بلدان كاملة بحجج وأكاذيب “سياسية”، يقوم بهذه المهمة في سوريا وفي المنطقة عموماً، عساكر يخلطون السياسة بالأيديولوجيا كعائلة الأسد، وصدام حسين والزعماء اللبنانيين وحتى نتانياهو.
السياسة لدينا هي أوامر فجة بقوة السلاح، ومدعاة للفخر بسبب التضحيات الأيديولوجية التي يقوم بها الشعب خدمة للمثل والشعارات السياسية، وعلى سبيل المثال، وفي نباهة فريدة، يُستخدم مصطلح “المرونة اللبنانية” للقول إنه على الرغم من كل ما يحصل في لبنان، وفساد المنظومة الحاكمة، اللبناني “مرن” وقادر على تجاوز المحن التي فُرضت عليه ولم يكن له دور في اختيارها.
اعتاد الخبراء السياسيون التصرّف على أنهم العالمون بخفايا الأمور، وتبنّوا مواقف تزدري السرديات الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية والأدبية، التي لامست بشكل أو بآخر انفجارات المنطقة، وانهيارات المنظومات البنكية في عام 2008، ولكن ظل الترفّع هو سمة علماء السياسة.
دروس للسوريين !
وفي عام 2023، كتب نيكولاس فان دام الدبلوماسي والباحث مقالاً بحثياً طويلاً بـعنوان “الدروس التي ينبغي تعلّمها من الثورة السورية والدروس التي كان يجب تعلّمها قبل فترة طويلة”، الدروس كانت توجيهات للسوريين بعدم الاحتجاج، وبناء حوار مع الأسد لرفع العقوبات، والبدء في إعادة بناء البلاد، وأسباب هذا التنازل هي وحشية النظام والجماعات الطائفية المتحالفة مع النظام.
يستنتج فان دام أن الأسد قوي لأنه عاد إلى الجامعة العربية، وبالتالي فإن إسقاط النظام صعب أو بعيد المنال. المقالة، وكما هو حال العديد من الرؤى السياسية، لم تتطرّق إلى قضية المعتقلين، ولم تتطرّق إلى الكبتاغون ومراوغات الأسد وابتزازه الجميع بملفات القاعدة وتهديداته بـ”تفجير المنطقة”.
وربما كان العزوف عن التطرّق إلى هذه المواضيع هو افتقار “الخبراء السياسيين” إلى حيثيات الصفقات السوداء، وعجزهم عن وضع حلول لمجابهة هذه التحديات، وبالتالي يكون الكلام السياسي الموزون هو الذي لا يقول ولا يشرح ولا يقدم حلولاً.
تغير “درس” فان دام في مقال آخر كتبه بعد ثلاثة أيام من سقوط النظام، ورأى فيه أن ثورة جديدة ضد نظام الأسد كانت شأناً لا يمكن تفاديه، وفي الوقت الذي اعتبر فان دام أن انتصار الأسد كان بعودته إلى جامعة الدول العربية، يصف أحمد الدالاتي القيادي في إدارة العمليات العسكرية، عودة الأسد إلى الجامعة العربية هي اللحظة التي تيقّنوا فيها أن الأسد هُزم!.
وعلى الصعيد السوري كان هناك اقتناع تام عند العديد من السوريين الذين اصطفوا إلى جانب الأسد، أو الذين عارضوه، أن الأسد ذكي، وأنه يعرف ما يقوم به، وأن سياسات التقشّف، وسياسيات التلاعب بالكلام والفذلكات اللغوية كانت مناورات سياسية، ليتبين فيما بعد أن السياسي المحنك قد سرق نقود البلد وهرب، وأن اللصوصية التي قام بها كانت شديدة البساطة إلى درجة ترفّعت عنها حذلقات العلوم السياسية.
– مسرحي وأكاديمي سوري
درج
—————————————
سوريا… الأسهل إسقاط النظام… الأصعب بناء الدولة/ محمد الرميحي
تحديث 08 شباط 2025
الأمل أن النظام الجديد في سوريا سوف يبني الدولة المستقلة الآمنة والنامية والحاضنة لكل مكونات شعبها. سقوط النظام السابق تقاطع مع مرحلة ليست سورية فقط، ولكن أيضاً عربية، فهو تقاطع مع توريث الجمهوريات وأيضاً مع حكم الآيديولوجيا. بالثورة السورية الأخيرة ماتت الآيديولوجيا في الحكم، سبقها موت الآيديولوجيا القومية في الحكم، وأيضاً الآيديولوجيا الدينية كما في السودان، لم يبقَ في الشرق الأوسط دولة تحكم بالآيديولوجيا غير إيران، وذلك لافت لدارسي التغييرات في المنطقة.
تُواجه الإدارة الجديدة في سوريا عدداً لا يُحصى من التحديات، في محاولتها التغلُّب على تعقيدات الحكم في بلد دمرته سنوات من الصراع، والعقبات متعددة الأوجه، تتراوح بين عدم الاستقرار السياسي، والدمار الاقتصادي، والتشرذم الاجتماعي، والضغوط الدولية.
عدم الاستقرار السياسي أحد أهم التحديات؛ حيث تركت الحرب الأهلية السورية، التي بدأت عام 2011، فراغاً كبيراً في السلطة، ومشهداً سياسياً مجزأ. لا تزال فصائل مختلفة، بما في ذلك بقايا النظام الأسدي، وجماعات المعارضة، والمنظمات المتطرفة، وجماعات الأقليات تتنافس على السيطرة. إنشاء حكومة متماسكة وشاملة، يُمكنها كسب ثقة ودعم السكان السوريين المتنوعين، عرقاً وثقافة، هي مهمة شاقة. كما يتوقع من الإدارة الجديدة أيضاً أن تبحر في ميزان القوى الدقيق بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، ولكل منهم مصالحه وتأثيراته الخاصة في المنطقة.
فالاقتصاد السوري في حالة خراب؛ حيث دُمرت البنية التحتية بسبب سنوات من الصراع. وتُواجه الإدارة الجديدة المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء اقتصاد البلاد من الألف إلى الياء. فمعدلات البطالة مرتفعة بشكل يُثير القلق، ويعيش كثير من السوريين في فقر. تعطَّلت الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق، وسوف يتطلب تنشيط الاقتصاد مساعدات دولية كبيرة، واستثمارات، واستراتيجية شاملة لاستعادة البنية الأساسية، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للإدارة معالجة قضية الفساد المتفشية، التي تعوق جهود التنمية، وتديم عدم المساواة.
على أن التحدي الأكبر أنه لا يُبدَّل بحكم آيديولوجي حكم آخر من نوع مختلف من الآيديولوجيا! ذلك قاتل للطموحات السورية، وعلى تناقض مع مسيرة العالم نحو الحكم الرشيد.
الصعوبات متعددة، أولاً أن هناك شريحة من المجتمع السوري أصبحت بسبب الظروف لها «استقلال نسبي في منطقة كبيرة من سوريا»، وهم الإخوة الكرد السوريون، هذا الملف معقد، فهناك مَن يرى من الكرد «الاستقلال التام»، وهي نظرية مثالية أدَّت إلى كثير من المشكلات للكرد في مناطقهم المختلفة، بما فيها تركيا، وآخرون من كرد سوريا يرون النموذج العراقي مخرجاً، ولكن ذلك أيضاً كانت له ظروفه الخاصة، الأوفق أن يكون الكرد جزءاً من المكونات السورية، تحت سقف دستور حديث، فالبقاء في المكان سوف يسبب للكرد كثيراً من المشاكل، ويعطل في الوقت نفسه قيام سوريا الجديدة.
أما ثانياً فهو الطموح القومي المثالي، الذي تحمله شريحة سورية، ربما عابرة للمكونات، وهو طموح في تحقيق دولة مثالية في التو واللحظة، وهي عملية تكاد تكون مستحيلة. وستظل هذه الشريحة تُمارس مزايدات لا تنفك عن المثاليات، ما يعوق في الوقت نفسه قيام الدولة السورية المبتغاة. هناك أيضاً الموحدون الدروز في السويداء، والعلويون في الساحل، والمسيحيون وغيرهم من الجماعات، لكل منهم مظلمة مع النظام القديم، وله مطالب من النظام الجديد، بعضها يكاد يكون مستحيلاً.
ولا يمكن ثالثاً تجاوز هاجس «ما يمكن أن يُطلق عليه حكم الإسلام الحركي»، وتحمله شريحة كبيرة ترى أنها الأغلبية، وترى أيضاً أن تطبيق أفكارها الآيديولوجية أحق أن تتبع، وقد عانت ربما الحجم الأكبر من عنت وظلم النظام السابق.
أمام هذه المكونات الثلاثة، إضافة إلى الطموحات الإقليمية والدولية في سوريا، يجد النظام الجديد أنه يسير على صراط من السهل أن تزل الرجل فيه.
لا نستطيع أن نتجاهل طموح إيران في العودة إلى سوريا، ولا طموح موسكو في البقاء في الساحل السوري، الأولى خسرت خسارة فادحة، وسوف تحاول جاهدة بعد الخروج من الباب أن تعود للدخول من الشباك، من خلال أذرعها في الجوار، وشبابيك سوريا مشرعة حتى الآن، بسبب الاختلاف الداخلي الذي وصف سابقاً، أما روسيا فإن حلمها القديم والمتجدد بأن تضع أقدامها في المياه الدافئة يجب عدم التقليل منه أيضاً.
زيارة أحمد الشرع الأولى إلى المملكة العربية السعودية هي خطوة سياسية ذكية، فهي الحاضنة العربية والبوابة لدول الخليج وللعالم، والملاذ الطبيعي لطموح الإدارة الجديدة، فهي تضيف ولا تضعف، تسعف ولا تعطل، كما أن الزيارة الثانية إلى تركيا، التي تربطها بمجموعة الشرع علاقات قديمة أيضاً، من الخطوات الذكية التي يمكن أن يُبنى عليها.
حتى الساعة، فإن التصريحات القادمة من كبار مسؤولي الإدارة السورية الجديدة مطمئنة، ولكن من الخطأ الاستهانة بالتحديات الكبرى التي تواجه سوريا الجديدة، ولعل هناك خطوتين متلازمتين تحتاج إليهما الإدارة الجديدة، الأولى، السرعة المعقولة في بناء المؤسسات الموعودة، والثانية الاهتمام بالإعلام بأشكاله المختلفة والحديثة، حتى يمنع تسمم الأجواء بأخبار كاذبة وملفقة.
آخر الكلام: المخاطر متعددة، والحصافة أن تسبق خطوات النظام الجديد أمواج الاحتمالات ويركن إلى الدعة.
الشرق الأوسط
—————————–
ملامح شراكة إستراتيجية بين سوريا وتركيا/ عباس شريفة
رئيس سوريا أحمد الشرع يزور تركيا للقاء الرئيس أردوغان
8/2/2025
جاءت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة في الرابع من فبراير/شباط الجاري واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق محلي وإقليمي حساس جدا، فهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لدولة غير عربية، وتكتسب الزيارة أهميتها من حجم الملفات التي تهم البلدين وعلى رأسها التعاون العسكري والاقتصادي.
وتشمل هذه الملفات العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة الإعمار، وملف اللاجئين السوريين في تركيا، والتحديات الأمنية المتعلقة بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق شمالي شرقي سوريا بدعم أميركي، ونشاط تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية، ومحاولة التنظيم إعادة ترتيب هياكله التنظيمية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يناقش هذا التقرير أهمية الملفات التي تجمع بين البلدين وانعكاس الشراكة على أوضاعهما الداخلية وعلاقتهما مع المحيط الإقليمي في مرحلة تتم فيها إعادة ترتيب المحاور الإقليمية بعد الانكفاء الإيراني عن سوريا ولبنان، ومسارعة الكثير من الدول الإقليمية لشغل الفراغ الإستراتيجي في سوريا.
أولويات الشراكة
تضع القيادتان السورية والتركية في حسابهما ترتيبا دقيقا لخطوات محسوبة ومنسقة تجاه بناء الشراكة بينهما، فهناك العقبات القانونية المتمثلة في العقوبات الدولية والأميركية التي بقيت من تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتحديات الأمنية المتمثلة ببقاء منطقة شمالي شرقي سوريا خارج سيطرة دمشق.
ومن الأولويات أيضا العمل على مسار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من خلال استثمار العلاقات الجيدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي، ودور تركيا الدولي والإقليمي في حشد مواقف الدول في الأمم المتحدة للتصويت على رفع العقوبات، وهذه العقبة إن تم تجاوزها سيشرع البلدان في بحث قضية إعادة الإعمار التي سيكون لتركيا دور رئيسي فيها.
وكذلك يأتي توحيد الجغرافيا السورية على رأس التحديات الأمنية المتمثلة في مشروع قوات “قسد”، ويبدو أن دمشق وأنقرة تتبادلان الأدوار في معالجة الملف، فبينما ترفع أنقرة العصا الغليظة وتهدد بعمل عسكري ضد قسد، ترفع دمشق الجزرة وتعرض خارطة طريق سياسية لحل ملف شرق الفرات سلميا من خلال المفاوضات، وإقناع الولايات المتحدة برفع الغطاء عن قسد.
يبدو أننا هنا أمام حل مركب يمزج بين الضغط السياسي والعسكري مع إعطاء قسد قاربا للنجاة ينهي هذا الملف الذي تحاول إسرائيل وإيران الاستثمار فيه للتأثير في المعادلة الداخلية السورية، لكن مع تعثر المفاوضات بين دمشق وقسد فإن اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الملف بات هو الأقرب لخيارات دمشق وأنقرة.
التعاون العسكري والأمني
لدى تركيا 129 نقطة عسكرية وأمنية داخل سوريا، وبدأت بالانتشار في عام 2016 مع إطلاق عملية درع الفرات ضد تنظيم الدولة، تنتشر هذه القواعد على امتداد مناطق الشمال والشمال الغربي لسوريا، وفي مدينة تل أبيض ورأس العين.
حاولت تركيا سابقا تشريع وجودها العسكري من خلال مساعي التطبيع مع النظام السوري، وتعديل اتفاقية أضنة بحيث يتجاوز الوجود العسكري حدود 5 كلم إلى 30 كلم داخل الأراضي السورية، والآن أصبحت الفرصة مواتية لدمشق وأنقرة كي تبحثا التعاون العسكري برؤية أكثر شمولية.
بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر تركية، تسعى أنقرة مرة أخرى إلى تثبيت وجودها العسكري في سوريا من خلال السعي لإبرام اتفاقية للدفاع المشترك، يفضي لإعادة الانتشار العسكري التركي في سوريا بناء على التحديات الأمنية التي تهدد البلدين، والتي تتضمن نشاط تنظيم الدولة وفلول النظام السوري التي تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا.
وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها سبق زيارة الشرع إلى تركيا بأنه من المخطط أن يناقش مع الجانب التركي إنشاء قواعد دفاع جوي وسط البلاد لحماية الأجواء السورية من أي نشاط معاد يمكن أن يستهدف سيادة البلاد، وذكر وزير الدفاع التركي يشار غولر في وقت لاحق بعد الزيارة أن وزارته أعدّت خططا في هذا الصدد، لكنه نفى حصول اتفاق وقال إنه من المبكر الحديث عن ذلك.
تحالف إقليمي
ومع أهمية الدور التركي في مواجهة تنظيم الدولة، يبدو أن أنقرة راغبة في تشكيل تحالف إقليمي يضم كلاً من الأردن والعراق وسوريا وتركيا لمواجهة التنظيم، وعدم حصر ورقة مكافحة الإرهاب بيد قسد والولايات المتحدة التي تتخذها ذريعة لاستمرار تقديم الدعم والحماية لها.
وفي السياق كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مبادرات إقليمية ستطلقها بلاده لمكافحة تنظيم الدولة، “واتخاذ خطوات تهدف إلى إنشاء آلية مشتركة بين تركيا والعراق وسوريا والأردن”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وفي ظل رغبة دمشق في تنويع مصادر تسليح الجيش السوري وعدم الاكتفاء بالتسليح الروسي، تبدو تركيا المتقدمة في مجال التصنيع العسكري وبوصفها دولة في حلف الناتو وحليفا للثورة السورية، وجهتها المناسبة.
وكشف تقرير لوكالة رويترز أن الاتفاقية الدفاعية قيد النقاش بين الجانبين ستمنح سوريا الدعم التركي إذا تعرضت لتهديد مفاجئ، كما ستشمل تدريب الجيش السوري وتزويده بمعدات عسكرية متطورة.
كما أن العلاقات العسكرية التي نسجتها فصائل المعارضة السورية مع الجيش التركي، وخوض العديد من المعارك معا، وإشراف تركيا على تقديم التدريب لبعض الفصائل، يمكن أن يؤسس لهذا التعاون.
هذا التعاون العسكري محفوف بالكثير من التحديات التي تتمثل في احتمال معارضة الولايات المتحدة، وتحوّل سوريا إلى ساحة تنافس عربي تركي، لكن يمكن في النهاية للوجود التركي والعربي أن يشكل ضمانة لعدم عودة إيران لشغل الفراغ الجيوإستراتيجي في سوريا.
وسيمكن ذلك أنقرة من مساعدة دمشق في بناء مؤسسة أمنية احترافية قادرة على التعاون وتبادل المعلومات الأمنية مع دول المنطقة لمواجهة الأخطار المشتركة، خصوصا مع توجه دمشق لتنويع تحالفاتها الإقليمية واعتبار علاقتها بمحيطها العربي هي نقطة الارتكاز التي تنطلق منها لصياغة علاقاتها الدولية والإقليمية الأخرى.
التعاون الاقتصادي
ساهم وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا، الذين يتجاوز عدد 3 ملايين لاجئ، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشعبين السوري والتركي، فقد لعبت العمالة السورية دورا محوريا في الاقتصاد التركي.
فقد دخل كثير من المستثمرين السوريين إلى سوق العمل التركي، كما لعبت المدن الصناعية التي أسستها الحكومة المؤقتة في الشمال السوري بالتعاون مع تركيا دورا مهما في تدوير عجلة الإنتاج في الشمال السوري.
لكن مع سقوط النظام السوري، والبدء بترسيخ الاستقرار الأمني، ورفع العقوبات عن سوريا، يمكن للتعاون الاقتصادي بين دمشق وأنقرة أن يشمل العديد من المجالات التي تفتح مسار التعافي المبكر الذي يدعم إصلاح البنية التحتية وتدوير عجلة الإنتاج ليلبي طلب السوق الداخلية.
كما تسعى تركيا من خلال شركات الإنشاءات المحلية لدخول مسار إعادة الإعمار إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
معبر تجاري
بعد سقوط نظام الأسد وانتهاء النفوذ الإيراني، تستعيد سوريا أهميتها بوصفها معبرا تجاريا يصل بين الخليج العربي وبين تركيا وأوروبا، ويكتسب الطريق الدولي “إم 5” الواصل بين معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية ومعبر نصيب على الحدود الأردنية السورية أهمية إستراتيجية ربما تدفع تركيا ودول الخليج العربي للاستثمار بتأهيل الطريق بدلاً من الاعتماد على طريق التنمية العراقي بسبب بعد المسافة، ومن المتوقع أن يسهم الشحن البري عبر سوريا في اختصار المدة وتخفيف تكاليف النقل الجوي والبحري إلى دول الخليج.
ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع توقعات بزيادة الصادرات التركية إلى سوريا، مع الإشارة إلى حذر دمشق من علاقة تجارية غير عادلة تحول سوريا لمجرد سوق مستهلك للبضائع التركية على حساب نشاط التجارة الداخلية والقطاع الصناعي والزراعي في سوريا.
وفي الرؤية الإستراتيجية لمشاريع الطاقة في المنطقة، يشكل خط الغاز القطري التركي الذي يعبر من السعودية والأردن وسوريا أهمية كبيرة على مستوى التعاون بين دمشق وأنقرة، والذي يهدف لربط قطر مباشرة بأسواق الطاقة الأوروبية.
وكان من المقرر أن يمتد إلى الحدود السورية التركية وينضم إلى شبكة أنابيب الغاز المارة في تركيا. ومن تركيا، يتم بعد ذلك ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي بخط أنابيب نابوكو.
ويتوقع أن تقوم أنقرة ودمشق بإعادة تفعيل اتفاق الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا، لكن هناك الكثير من التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، وأبرزها الدمار الواسع في البنية التحتية للشبكة في سوريا، مما يدفع لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في إصلاح البنية التحتية لشبكات الطاقة والكهرباء.
المصدر : الجزيرة
————————————
أحمد الشرع عراقيا… وعل دمشقي في أحراش جهنم/ اسماعيل درويش
أعوام السجن الأميركي قادته إلى “داعش” قبل أن ينشق عن التنظيم الإرهابي ليبدأ مشروعه الطامح نحو “عرين الأسد”
السبت 8 فبراير 2025
ملخص
غادر أحمد الشرع سوريا إلى العراق قبل أربعة أيام من الغزو الأميركي، وبقي هناك أقل من شهر ثم عاد إلى دمشق، وفي عام 2006 عاد ثانية إلى العراق، لكنه تعرض للاعتقال من قبل القوات الأميركية بعد أشهر قليلة، وبقي في السجن يحمل بطاقة شخصية على أنه مواطن عراقي، وفي مارس 2011 أُطلق سراحه وعاد إلى سوريا بعدما ظنت عائلته أنه توفي في العراق.
عادة ما يحظى زعماء العالم باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام والصحافيين والباحثين وحتى الجماهير، سواء المؤيدة لذاك الزعيم أو المعارضة له، ويصل هذا الاهتمام إلى حد البحث عن أدق تفاصيل حياته وطفولته، والحياة الخاصة له ولأفراد عائلته، وفي مثل هذه الحالات تنتشر الإشاعات وتتعدد الروايات وتكثر المصادر، منها الصحيح ومنها الملفق.
واليوم أضحى الرئيس السوري أحمد الشرع زعيماً يحظى بالاهتمام ذاته، وهو الآخر لم يسلم من كثرة المتحدثين عنه وعن حياته، فيراه محبوه بطلاً حرر البلاد من مجرم حرب، وطرد منها ميليشيات طائفية كانت تعيث فيها فساداً وإفساداً، وبيض سجوناً شهدت أبشع أنواع التعذيب في العصر الحديث، ويرون أيضاً أنه رجل براغماتي محنك، يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والدولة المدنية التي يبحثون عنها، والتي دفعوا لأجلها ثمناً باهظاً.
أما أعداؤه فيركزون على خلفيته الراديكالية المتطرفة، مؤكدين أن التغيير الذي جاء به لا يغفر ماضيه في العراق وسوريا، لكن ماضي الرجل فيه كثير من المغالطات وكثير من الإشاعات، فقد كان زعيم “هيئة تحرير الشام”، التي لها ما لها وعليها ما عليها مثلها مثل باقي الفصائل التي قاتلت في سوريا. في هذا التقرير سنركز على الفترة التي قضاها أحمد الشرع في العراق ما بين 2003 و2011، وأهم المحطات التي عبرها.
المحطة الأولى في العراق
مطلع عام 2003 بدأت المؤشرات تزداد بصورة متسارعة في شأن غزو أميركي مرتقب للعراق، وهنا بدأ كثير من الشباب السوريين الهجرة إلى العراق للمشاركة في “مقاومة الاحتلال الأميركي”، ولم يكن كل من ذهب إلى العراق في تلك الفترة متطرفاً، بل إن معظمهم كان من الشباب السوريين العاديين، وكثير منهم ذهب بدوافع قومية.
في ذلك الوقت كان أحمد الشرع شاباً يبلغ من العمر 21 سنة، ذهب إلى مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ودخل العراق بصورة غير قانونية، بمعنى أنه لم يدخل من معبر “القائم” الرسمي، وكان ذلك تحديداً في الـ15 من مارس (آذار) 2003، قبل أربعة أيام من بداية الغزو الأميركي، وبقي هناك لفترة وجيزة ليعود إلى سوريا في الـ10 من أبريل (نيسان) 2003 من معبر “القائم”، وهنا تعرض للتحقيق من قبل فرع الأمن العسكري بدير الزور، أو ما يسمى “الفرع 243″، بسبب دخوله بطريقة غير مشروعة، لكنه لم يتعرض للاعتقال إذ سُمح له بالعبور بعد إجراء تحقيق موقت، وبعد أشهر عدة استدعاه فرع فلسطين، أو ما يعرف بـ”الفرع 235” للسبب نفسه، وأيضاً لم يتعرض للاعتقال، إذ كان صغير السن وليست لديه تهم جنائية ولا شبهات أخرى سوى رحلته إلى العراق لأسابيع قليلة.
العودة الثانية إلى العراق
بعد عودته من العراق بقي الشرع يعيش في حي المزة بدمشق يتردد باستمرار على “مسجد الشافعي”، وظل على هذه الحال حتى عام 2005 حين تعرض للاعتقال من قبل استخبارات النظام السوري، وحُقق معه بسبب نشاطه الديني ثم أُطلق سراحه فعاد مرة ثانية إلى العراق.
أثناء وجوده هناك قاتل الشرع ضد القوات الأميركية لأشهر عدة، وهناك التقى عدداً من قادة تنظيم “القاعدة” قبل أن يُعتقل على أنه مواطن عراقي. وتعليقاً على هذا يقول الكاتب والباحث السوري حسام جزماتي لـ”اندبندنت عربية”: “كان من عادة التنظيمات الجهادية أن تزود مقاتليها ببطاقات شخصية عراقية كي تعاملهم السلطات الأمنية على أنهم مقاومون محليون، لا مجاهدون عابرون للحدود، في حال احتجازهم”.
ويوضح الباحث أن هذه الحيلة كانت معروفة لدى القوات الأميركية، لذلك عمدت إلى “الاستعانة بمحققين محليين يجرون للمعتقل فحصاً للهجة، وعلى رغم الأشهر القليلة التي أمضاها هناك تمكن الشرع من اجتياز الاختبار وسجن على أنه مواطن عراقي”.
وبما أن أحمد الشرع مسجون لدى الأميركيين على أنه مواطن عراقي، انقطع التواصل بينه وبين عائلته في سوريا، حتى ظنوه قتل في العراق، لكنه فاجأهم بعد اندلاع الثورة السورية بعودته إلى البلاد.
شهادة العدناني
مكث الشرع في السجون الأميركية قرابة خمسة أعوام تعرف خلالها إلى عدد من الجهاديين الذين أصبحوا لاحقاً قادة في تنظيم “داعش” الإرهابي، من بينهم المدعو أبو محمد العدناني الذي أصبح لاحقاً المتحدث الرسمي باسم تنظيم “داعش”، لكن العلاقة بين الشرع والتنظيم لم تكن على ما يرام، وفي مارس 2011 أُطلق سراح الشرع ليعود إلى بلاده في أغسطس (آب) من العام نفسه.
في عام 2012 كتب العدناني ما يسمى “شهادة العدناني بالجولاني”، وهي رسالة من صفحات عدة يتحدث فيها عن أحمد الشرع، فيثني عليه تارة ويذمه أخرى، ومما جاء فيها حديثه عن الفترة التي قضاها العدناني مع الشرع في السجن، يقول ما نصه “جمعنا مخيم واحد لظروف معينة، وما كان على الأخ سوى بعض الملاحظات من قبل الإخوة حول منهجيته، وقد سحبته لخيمتنا وبقينا معاً في الخيمة نحو ثلاثة أشهر، ولم أرَ منه طوال هذه الفترة إلا أحسن الأخلاق، وكان كثير القراءة والمطالعة، كثير الصمت، وكانت علاقته طيبة مع الإخوة في الخيمة، ولم تحدث له أي مشكلة”.
بعد ذلك يسرد العدناني في “شهادته” تفاصيل أخرى بعد السجن، فيقول إن الشرع لم يكن يطيع أوامر زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، وكان يريد القتال في سوريا وحده، واتهمه بأن لديه “خللاً في منهجه”. ويتحدث أيضاً عن عائلته، فيقول ما نصه “يعتز بوالده الشيوعي، ويمدح ما فيه من صفات نبيلة حسب زعمه، ويزوره والده وأخوه في مضافته، وهم لا يصلون بل يجادلون في الباطل”.
المدعو أبو محمد العدناني اسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم تنظيم “داعش” الإرهابي حتى الـ30 من أغسطس 2016 عندما قتل قرب مدينة حلب شمال سوريا.
إذاً من خلال شهادة فلاحة يتضح أن أحمد الشرع يعد عدواً لدوداً للتنظيم الإرهابي، علماً أن الشرع عندما كان في السجون العراقية حمل ألقاباً عدة أبرزها “أبو أشرف”.
عن عودته من العراق إلى سوريا تحت اسم “أبو محمد الجولاني”، يقول الباحث حسام جزماتي إن “عائلته لم تعرف أن ابنها هو الجولاني الذي بدأ الحديث عنه في الأخبار إلا في وقت متقدم نسبياً، بعدما قدر هو أن الأمر لن يخفى طويلاً، وأن بقاء العائلة آمنة في منزلها في حي الفيلات الشرقية مسألة وقت، فأمَّن خروج والديه إلى الشمال السوري ريثما يغادران البلاد، أما إخوته فمن لم يكن منهم يقيم في الخارج أصلاً بقصد العمل كان عليه أن يغادر أيضاً”.
اليوم أضحى أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية، وهو في الـ43 من عمره، إذ ولد في العاصمة السعودية الرياض في الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وقضى في الرياض سبعة أعوام من عمره قبل أن يغادرها طفلاً إلى دمشق، ليقود نهاية 2024 حملة عسكرية حملت اسم “ردع العدوان” أسفرت عن إسقاط النظام السوري السابق، قبل أن يُختار الشرع رئيساً للبلاد في “مؤتمر النصر” نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
————————–
هل تصبح سوريا الخطة “ب” أمام ترمب لحل أزمة غزة؟/ إنجي مجدي
تحدثت مصادر عن عرض أميركي لدمشق، حيث يعيش نحو 450 ألف فلسطيني في البلاد منذ عقود طويلة
السبت 8 فبراير 2025
يتفق المراقبون في القاهرة ولندن على استبعاد رضوخ مصر والأردن لضغوط واشنطن في شأن تهجير فلسطينيي غزة، وهي “أول خطوة في تصفية القضية نهائياً” وفق وصف جاد، واستبعدت سفيتلوفا وهي عضو سابق بالكنيست الإسرائيلي، أن توافق أية دولة عربية على “استقبال أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين، بخاصة إذا كان الهدف هو نقلهم الدائم خارج فلسطين”.
يصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مقترحه لنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، بدعوى إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية على مدى 16 شهراً. هدأت الأمور بعد ثلاثة تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي في هذا الصدد، وكان أحدث تصريح يرد فيه على رفض القاهرة وعمان خطته، حين بدا عنيداً ومتحدثاً بلهجة حادة قائلاً “سيفعلون ذلك، نحن قدمنا لهم كثيراً، وسيفعلون”، ثم عاد ليلقي بحجر أكبر في البركة الهائجة بالفعل ليتحدث عن خطة للسيطرة على القطاع.
قدم الرئيس الأميركي مقترحه في شأن غزة مع الإشارة إلى خطته، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، متحدثاً عن إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن ودول أخرى، وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، ومع ذلك، لا يزال مشروع ترمب غير واضح، ففي ظل الرفض المصري الأردني المتكرر لإعادة توطين فلسطينيي غزة، أشار سيد البيت الأبيض إلى “دول أخرى”، ولم يحدد تفاصيل في شأن كيفية نقل نحو مليوني فلسطيني.
عرض أميركي لدمشق
في هذه الأثناء، تحدثت مصادر لمراسل “اندبندنت عربية” في سوريا، في شأن اقتراح قدمه مسؤولون أميركيون للحكومة السورية الجديدة في شأن استضافة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في مدن سكنية جديدة تُبنى ضمن مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع إسهام الولايات المتحدة في دعم عملية الاستقرار والازدهار الاقتصادي داخل البلاد.
ويعيش نحو 450 ألف فلسطيني في سوريا في مخيمات عدة منذ عقود طويلة، غير أن المخيم الأكبر هو اليرموك الذي بُني عام 1957 خارج العاصمة دمشق، وعلى رغم أنهم يعيشون منذ عقود، فلا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية للحفاظ على حقهم في العودة إلى أراضيهم التي أجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948، وأخيراً أثيرت إشاعات في شأن منح الجنسية السورية للفلسطينيين المقيمين داخل سوريا وإلغاء المخيمات وتوزيع الفلسطينيين على المدن الكبرى.
يعتقد بعض المراقبين في المنطقة أن ترمب ربما يستغل الوضع السوري وحاجة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الاعتراف والدعم الدولي، ويقول أستاذ السياسة، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عماد جاد، في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن إصرار مصر والأردن على رفض قبول سيناريو التهجير يجعل سوريا الخيار الأمثل بالنسبة إلى الأميركيين والإسرائيليين، ويقول “الجولاني (في إشارة إلى الأسم السابق للرئيس السوري) يحتاج إلى الاعتراف الدولي، كما يحتاج إلى التمويل من أجل إعادة إعمار سوريا، كذلك فإنه (الرئيس السوري) يقف على يمين جماعة الإخوان المسلمين الذين يؤمنون بالأساس أن الأرض ليست الوطن بل الدين، وهنا يمكن الإشارة إلى أن سكان قطاع غزة مسلمون سنة، وربما هذا يفسر تصريحات ترمب الأخيرة بإرسال سكان غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى”، وبطبيعة الحال ثمة تنسيق بين الشرع والولايات المتحدة حتى قبل سقوط بشار الأسد.
ويلفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الحاجة إلى الدعم السياسي تجعل الشرع منفتحاً على مثل هذا المقترح، ويوضح “يريد الشرع أن يكون رئيساً لسوريا لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وقد تحدث في وقت سابق أن بلاده تحتاج إلى أربعة أو خمسة أعوام لتنظيم انتخابات رئاسية، كذلك يمكنه كتابة دستور يسمح له بفترة رئاسية ستة أعوام مع إضافة مواد تضمن له الترشح لمدد أخرى، بما يضمن وجوده لأعوام طويلة في السلطة”.
وبعد إعلانه توليه رئاسة سوريا، قال الشرع في مقابلة مع تليفزيون سوريا، الأسبوع الماضي، في شأن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، “لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين أربعة وخمسة أعوام وصولاً للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت”.
وعقب تنصيب الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر الشرع برقية تهنئة لترمب باللغة الإنجليزية على تطبيق “تيليغرام” قائلاً إنه “يثق” بأن ترمب سيكون القائد الذي “يحقق السلام في الشرق الأوسط”، وأضاف أن “ترمب يسعى إلى السلام ونسعى إلى استعادة العلاقات مع واشنطن الأيام القادمة… لدينا ثقة في أن الإدارتين ستغتنمان الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات البلدين”.
إعادة الإعمار
ويشير جاد إلى حاجة سوريا إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً، ويقول “عُرض على مصر قبلاً 200 مليار دولار للقبول بتهجير الفلسطينيين إليها، يمكن الاكتفاء بنصف هذا المبلغ لتحقيق الغرض في سوريا”.
ووفق جاد فإن مساحة سوريا بالنسبة إلى عدد سكانها ربما تشكل بُعداً آخر يدفع ترمب إلى التفكير فيها كخيار بديل، ويقول “تتساوى مساحة سوريا تقريباً مع مساحة فرنسا التي يعيش فيها 60 مليون نسمة، بينما يعيش في سوريا حالياً نحو25 مليون نسمة ومعظم مساحتها تسمح بالعمران السكاني. مشهد ترمب عندما أشار إلى صغر مساحة إسرائيل بالنسبة إلى مساحة الشرق الأوسط، هو انعكاس لأفكار اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن وجود 22 دولة عربية بمساحة 14 مليون كم مربع بينما مساحة فلسطين 25 ألف كم مربع، الفكرة الأولى كانت منح الفلسطينيين 2000 كم مربع من سيناء التي تبلغ مساحتها 64 ألف كم مربع”.
ويعتقد جاد أن كل الضجيج الذي يحدث هو تمهيد لتفريغ الضفة الغربية، حيث يوجد كل الارتباط المقدس بإبراهيم في القدس والخليل “أتصور أن الخطة الإسرائيلية قائمة على تفريغ غزة ثم تفريغ الضفة الغربية وهو ما تقوم به إسرائيل بالفعل”.
سوريا ليست خياراً
ويقول نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية محمد الدويري، في حديثه لنا إنه لم تكن هناك أية مواربة فى الموقفين المصري والأردني وهما الدولتان اللتان أشار إليهما ترمب لاستيعاب نحو مليون ونصف المليون من سكان غزة، إذ رفضت كل من مصر والأردن هذا المقترح تماماً وبوضوح تام، إلا أن ترمب حاول القفز على هذا الرفض بالإشارة “الغريبة” أيضاً إلى أن الدولتين ستقبلان المقترح، ويضيف “فى رأيى أن ترمب يسعى إلى تحويل الأوهام إلى حقائق وهو ما لن يحدث”، ومن ثم “ما أثارته الإدارة الأميركية في شأن وجود دول أخرى يمكن أن تستوعب الفلسطينيين الذين سيهجرون من غزة، هو استمرار لطرح تلك الأفكار الغريبة الغامضة، وكأن الإدارة على قناعة بأن موضوع التهجير سينفذ أياً كانت المعارضة المصرية والأردنية وأن واشنطن تمتلك البدائل من الدول التي ستحل هذه المشكلة”.
ويرى الكاتب والباحث السياسي السوري غسان إبراهيم، إنه لإقناع الفلسطينيين بالرحيل من غزة فلابد أن تكون الوجهة جذابة، فإذا رحلوا إلى سوريا أو مصر أو غيرها ولم يجدوا امتيازات فبطبيعة الحال سيتجهون إلى أوروبا. وأشار إلى أن مخيم اليرموك منهار ومنتهي بالفعل، وبالتالي تنتهي صفته كمخيم للاجئين الفلسطينيين حيث لم يتبق منه سوى الاسم وأصبح حى من دمشق الكبرى. واستبعد الباحث السوري أن تكون القضية الفلسطينية ضمن أولويات الإدارة السورية الحالية أو أي حكومة مستقبلية، مضيفا بالقول “الفلسطينيون أفشلوا بأنفسهم القضية، هم لا يحتاجون أحد ليُفشل قضيتهم”.
على الجانب الغربي، لا يوافق المراقبون في العواصم الغربية على سوريا “كخيار” متاح أمام ترمب لتهجير الفلسطينيين، وقالت زميلة برنامج الشرق الأوسط لدى معهد تشاثام هاوس في لندن كسينيا سفيتلوفا، في حديثها إلى “اندبندنت عربية” إن “سوريا هشة للغاية في الوقت الحالي، وهذا السيناريو يمكن أن يُعرض أية فرصة لإجراء تقدم في العملية السياسية هناك، للخطر”، وأضافت أن سوريا لا يمكنها أيضاً استيعاب مليون أو مليوني لاجئ، بينما يتعين عليها أن تتعامل الآن مع عدد هائل من مواطنيها الذين من المفترض أن يعودوا من الدول التي أصبحوا لاجئين فيها على مدى العقد الماضي، مشيرة إلى “أنه بلد فقير ومدمر وبحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية”، وأشارت سفيتلوفا إلى الحدود المشتركة بين مصر والأردن وغزة، وهو ما يجعل ترمب ينظر للبلدين باعتبارهما الأنسب لنقل سكان قطاع غزة.
ويرى إبراهيم أن مقترح تهجير الفلسطينيين هو “مجرد ورقة ضغط من ترمب بهدف تمرير مشروع إفراغ غزة من حماس، ودفع الدول العربية لتبني مشروع تكون فيه لغزة خصوصية ما فلا تكون ضمن حل الدولتين ولا ضمن إسرائيل”. وقال “ربما يفكر بتحويل غزة إلى مركز اقتصادي أو سياحي أو تجاري، فمشروعه قائم على فكرة إعادة بناء هذا القطاع على نموذج الجزر الجذابة للاستثمار. وفي النهاية يحتاج مشروع إعادة الاعمار إلى يد عامة ومن ثم تشغيل الفلسطينيين لأنه يصعب إقدام عمالة أجنبية لمنطقة غير آمنة، وبالتالي فإن فكرة التهجير هي ورقة مساومة لرفع السقف لأعلى ما يمكن حتى يجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات وبالتالي القضاء على حماس بتقديم نموذج بديل.”
يتفق المراقبون في القاهرة ولندن على استبعاد رضوخ مصر والأردن لضغوط واشنطن في شأن تهجير فلسطينيي غزة، وهي “أول خطوة في تصفية القضية نهائياً” وفق وصف جاد، واستبعدت سفيتلوفا وهي عضو سابق بالكنيست الإسرائيلي، أن توافق أية دولة عربية على “استقبال أي عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، بخاصة إذا كان الهدف هو نقلهم الدائم خارج فلسطين”، وفي تعليقات لـ”اندبندنت عربية”، وصف زميل المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن أتش أي هيلير، أن “فكرة نقل الفلسطينيين والوصف الصحيح لها التطهير العرقي للفلسطينيين، هي حقاً شاذة”.
وقال الدويري إن مصر التى تبنت طوال عقود سابقة مبدأ ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كأساس لاستقرار المنطقة لن تتنازل عن ثوابتها ولن تقبل تصفية القضية، لافتاً إلى حرص مصر على التواصل مع كل القوى الإقليمية والدولية بما فيها الولايات المتحدة لتوضيح خطورة هذا المقترح وعدم إمكان قبوله، مع التأكيد أن الخطوة العاجلة المطلوبة لحل أزمة غزة تتمثل في عنصرين أساسين الأول إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لدعم الأمور الحياتية لسكان القطاع ومساعدتهم على دعم حياتهم المعيشية، وأن تتولى واشنطن مسألة إعادة الإعمار من دون تهجير، والثاني إعطاء أمل للفلسطينيين بأن من حقهم إقامة دولتهم المستقلة التي ستعيش في سلام وأمن إلى جوار إسرائيل وذلك من خلال المفاوضات.
——————————-
معركة الحدود: كيف تحولت قرى لبنانية داخل سوريا إلى بؤر تهريب وصراع؟/ طوني بولس
تشكل القرى المتاخمة للحدود اللبنانية في منطقة القصير السورية ممراً رئيساً لعمليات التهريب وتمثل نقاط نفوذ لـ”حزب الله”
السبت 8 فبراير 2025
اشتبكت القوات السورية مع مجموعات لبنانية مسلحة متحالفة مع “حزب الله” (الصوة تخضع لحقوق الملكية الفكرية – مواقع التواصل اجتماعي)
ملخص
بدأت الإدارة السورية حملة عسكرية لضبط عمليات التهريب عبر الحدود مع لبنان، مما أسفر عن مواجهات مع مسلحين من عشائر لبنانية متورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات. وتعود مشكلة الحدود في هذه القرى إلى ترسيم الحدود الفرنسي غير الدقيق، حيث ظل سكانها اللبنانيون مرتبطين بلبنان على رغم وقوعها إدارياً ضمن سوريا. وخلال الحرب السورية عزز “حزب الله” نفوذه في هذه المناطق، مما أدى إلى تغيرات ديموغرافية وأمنية كبيرة.
تشهد الحدود اللبنانية – السورية تصاعداً في التوترات والاشتباكات بين الإدارة السورية الجديدة وعشائر لبنانية معروفة بعلاقتها مع “حزب الله”، لا سيما في بلدة حاويك الواقعة في ريف القصير غرب مدينة حمص. وتعود هذه المواجهات إلى إطلاق إدارة أمن الحدود السورية حملة موسعة على الحدود اللبنانية لضبط عمليات التهريب غير الشرعية، بدءاً من قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والمخدرات. خلال هذه الحملة اندلعت اشتباكات مع مسلحين من عشائر لبنانية مقربة من “حزب الله”.
وتعد هذه المناطق الحدودية معقلاً لعشائر لبنانية مثل آل زعيتر وآل جعفر الذين يمتلكون أراضي زراعية في الداخل السوري ويعرف عن بعض أفرادهم تورطهم في أنشطة التهريب. وتشير التقارير إلى أن هذه العشائر تعتبر هذه الأراضي جزءاً من ممتلكاتها التاريخية. ويعتقد أن “حزب الله” يستخدم هذه المناطق كطرق لوجيستية لنقل الأسلحة عبر بعض العشائر المحلية التي تسهل هذه العمليات مستفيدة من التضاريس الوعرة وصعوبة مراقبة الحدود. وسيطر “حزب الله” على هذه المناطق من جانبي حدود لبنان وسوريا بعد معركة القصير في 2013.
وأكد مصدر عسكري سوري (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن القوات السورية تواصل ملاحقة عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات والأسلحة عبر الحدود، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية التي يتم تنفيذها تهدف إلى مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية. وشدد على أنه لا يوجد أي تمييز بين المهربين السوريين واللبنانيين. وأضاف أن هذه العمليات لا تحمل أي دوافع انتقامية، بل تركز على مكافحة التهريب وتأمين الحدود بصورة شاملة من دون التفريق بين الجنسيات المتورطة.
القرى الحدودية
في تطورات متسارعة على الحدود اللبنانية – السورية شهدت قرى حاويك وجرماش وهيت الواقعة في ريف القصير الغربي اشتباكات عنيفة، مما أثار المخاوف حول استقرار المنطقة الحدودية. وبدأت الاشتباكات بعدما أطلقت إدارة أمن الحدود التابعة للحكومة السورية حملة أمنية شاملة بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والمخدرات. وذكرت مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان عدة أن المواجهات تدور مع عصابات تتبع لعشائر لبنانية متهمة بالوقوف وراء عمليات التهريب بالشراكة مع “حزب الله”. وقد عززت القوات السورية وجودها العسكري بإرسال ثلاث مجموعات من القوات الأمنية إلى المنطقة لتنفيذ عمليات اعتقال.
وفقاً لتقارير مختلفة استخدمت قوات الجيش السوري قذائف الهاون والمدفعية في مواجهة مع عناصر مسلحة وعشائر لبنانية مقربة من “حزب الله”. وتمكنت القوات السورية من تحرير عنصرين اختطفا خلال هذه الحملة، بينما ألقي القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات التهريب. وأفاد السكان بأن بعض المنازل تعرضت للتفجير، مما أجبر عديداً من العائلات على النزوح. وقالت مصادر لبنانية إن القصف المدفعي من الجهة السورية وصل إلى بلدة القصر اللبنانية، مما أدى إلى سقوط جريح وقتيل لبنانيين.
وفي محاولة لاحتواء الوضع تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الإدارة السورية والعشائر اللبنانية، حيث أفرج عن عدد من المحتجزين من كلا الجانبين. ومع ذلك لا تزال الأوضاع متوترة مع استمرار التعزيزات العسكرية من الطرفين في المناطق الحدودية.
تقع قرية حاويك على حدود متداخلة بين سوريا ولبنان، مما جعلها مركزاً استراتيجياً لعمليات التهريب. وتضم القرية سكاناً من الطائفتين الشيعية والسنية، وهو ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد للوضع السياسي والأمني.
معابر التهريب
تعد الحدود السورية – اللبنانية منطقة معروفة بعمليات التهريب البري، حيث تتجمع عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات مستفيدة من الفوضى الأمنية وحماية من “حزب الله” وعناصر الفرقة الرابعة من الجيش السوري، إذ باتت هذه العصابات تجد في المنطقة الحدودية بيئة صالحة للعمل بسبب الجغرافيا الجبلية والضعف في الرقابة على الحدود. ولطالما أشارت تقارير أمنية واستخباراتية الى دور مباشر أو غير مباشر لـ”حزب الله” في تسهيل عمليات التهريب عبر الحدود واستخدام المعابر غير الشرعية لتوسيع نفوذه وتمويل أنشطته في حين ينفي الحزب هذه الاتهامات، مشدداً على أن جهوده تركز على حماية لبنان من أي تهديد أمني. ومع تصاعد الاشتباكات تشير بعض التقارير إلى تحركات لعناصر “حزب الله” في المنطقة، إما لمواجهة هجمات القوات السورية، وإما لحماية مصالحه.
داخل الأراضي السورية
وفي تصريح صحافي أعلن مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد حسين غدار أن أي اشتباكات لم تحدث داخل الأراضي اللبنانية، بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية. وأضاف أن “الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري عزز وجوده وانتشاره على تلك الحدود”.
من جهة أخرى نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بياناً قال فيه إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم، وأنه “خلال تنفيذ الحملة وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين”.
سكان لبنانيون
وفي السياق لفت الكاتب السياسي إبراهيم ريحان إلى أن مسألة القرى اللبنانية الواقعة داخل الأراضي السورية تعد قضية متشابكة، حتى وإن لم تكن ذات أهمية كبيرة للنظام السوري في السابق. ومع ذلك فإن عائلات تلك القرى تعتمد عادة على التهريب، نظراً إلى قرب القرى المتقابلة بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية، مثل قرى “زيتا” و”ربلة” و”حويك”، التي يقطنها لبنانيون.
وأوضح ريحان أنه في منطقة الهرمل تسكن العائلات بالقرب من بعضها بعضاً، حيث نجد آل “جعفر” و”زعيتر” في المنطقة اللبنانية، وفي الجهة المقابلة داخل سوريا، مما يجعل التواصل والتبادل بين الجانبين أمراً طبيعياً. ولذلك ظل اعتمادهم على التهريب قائماً، سواء في زمن النظام أو بعده، كما أنهم واجهوا مشكلات مع النظام بسبب عمليات التهريب في السابق. وتابع أن المشكلات مع سوريا اليوم ترتبط بمسألة التهريب، بخاصة بعد التغيرات التي طرأت على الإدارة في سوريا. فالنظام السوري برئاسة بشار الأسد أصبح محط أنظار الدول والمجتمع العربي، ومن بين المطالب المطروحة إغلاق معابر التهريب بين لبنان وسوريا قدر الإمكان، كما حصل سابقاً من ناحية “معربون” التي تقع في البقاع الشرقي، بخلاف ما يحدث اليوم في منطقة الهرمل.
وتعد قرية “معربون” نقطة عبور نحو بلدة “بريتال”، ومن هناك تمتد الطرقات إلى الجرود المحيطة، مثل جرد بريتال والنبي شيت، ومنها نحو سرغايا والمناطق المجاورة. أما اليوم فإن هذه المناطق تقع ضمن ريف القصير وريف حمص، وهي تشهد نشاطاً تهريبياً مستمراً، لذلك من الضروري إعادة التفكير في هذه الطرقات وضبطها، بخاصة أن العائلات اللبنانية في هذه المناطق تعتمد بصورة أساس على التهريب كمصدر رزق، سواء في المحروقات أو المواد الغذائية وغيرها من السلع.
وأضاف ريحان أن طبيعة المنطقة تجعلها بؤرة للمهربين، حيث يقطن فيها بعض الشيعة، مقابل فصائل من هيئة “تحرير الشام” السنية، وأنه في ظل النظام العلوي السابق في سوريا كان هناك تسامح نسبي تجاه الطائفة الشيعية. أما اليوم ومع سيطرة النظام السني فقد تغير الوضع، مما أدى إلى تضييق الخناق على سكان تلك القرى الذين كانوا سابقاً يقاتلون في صفوف نظام الأسد أو يعملون معه.
وفي ما يخص صمت الدولة اللبنانية تجاه ما يحدث على الحدود قال “على ما يبدو أن الدولة اللبنانية لا تزال تتبع سياسة (النأي بالنفس) تجاه التطورات في سوريا، بخاصة في ظل عدم وجود قنوات تواصل فعالة على مستوى عالٍ مع القيادة السورية الجديدة”. وتابع قائلاً إن الهدف من ذلك هو قطع شريان التهريب الخاص بالحزب، وهو مطلب غربي – عربي مدعوم من المجتمع الدولي الذي يراقب الوضع في سوريا ويضع هذه القضية ضمن مجموعة من الأمور المطلوبة.
من فرنسا إلى سوريا
وتتداخل الحدود بين لبنان وسوريا بسبب غياب الترسيم بين البلدين بتداخل جغرافي وسكاني عميق، بخاصة في منطقة القصير وريف حمص الغربي. وتعود هذه الظاهرة إلى عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية، حيث توجد قرى مثل حاويك وزيتا وجوسية والسماقيات وفكة والدمينة الغربية وقارة والقصير التي يقطنها لبنانيون على رغم أنها تقع رسمياً داخل الأراضي السورية.
ويرجع هذا التداخل إلى عوامل عدة منها عدم ترسيم دقيق للحدود خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1920-1943)، إذ تعاملت فرنسا مع لبنان وسوريا كوحدتين إداريتين منفصلتين دون تحديد دقيق للحدود بينهما على رغم صدور القرار الدولي 1680 الذي يشدد على ضرورة توضيح النقاط الحدودية، إضافة إلى العلاقات العائلية والقبلية التي ربطت العشائر والعائلات في سهل البقاع اللبناني وريف حمص السوري، مما أدى إلى امتلاك لبنانيين أراضي ومزارع داخل الأراضي السورية والهجرة الموسمية، إذ كان اللبنانيون ينتقلون للعمل في الأراضي الزراعية داخل سوريا، بخاصة أن مناطق القصير وريف حمص كانت تشتهر بزراعة القمح والتبغ والفاكهة.
وخلال الانتداب الفرنسي تم تعديل الحدود بين لبنان وسوريا وفق المصالح السياسية والاقتصادية، وتم ضم بعض المناطق إلى سوريا على رغم ارتباطها الوثيق بلبنان. وتعود الأسباب إلى القرار الإداري الفرنسي، فعلى رغم أن بعض المناطق كان يسكنها لبنانيون، فإن فرنسا ألحقتها إدارياً بسوريا بسبب اعتبارات جغرافية وعسكرية، وكذلك تقسيم الموارد الزراعية والمياه، حيث تعد بعض المناطق مثل القصير وحاويك وزيتا غنية بالموارد الزراعية والمياه، لذا فضلت فرنسا إبقاءها ضمن سوريا لضمان التحكم في الري والممرات التجارية، إضافةً إلى الأهمية الاستراتيجية، إذ تعد القصير ومحيطها منطقة مهمة عسكرياً، بخاصة أنها قريبة من طريق حمص – دمشق الرئيس، مما جعل فرنسا تفضل بقاء هذه القرى تحت السيطرة السورية لأسباب أمنية.
واقع جديد
وخلال الحرب السورية لعبت هذه القرى دوراً كبيراً في النزاع، بخاصة مع دخول “حزب الله” إلى المنطقة عام 2013 خلال معركة القصير، مما أدى إلى تهجير قسم من سكانها أو فرض واقع أمني جديد، حيث عزز “حزب الله” وجوده هناك، وحول منطقة القصير إلى نقطة ارتكاز استراتيجية له تستخدم كمعبر لنقل السلاح والمقاتلين بين لبنان وسوريا.
وفي السياق يوضح العميد المتقاعد سعيد القزح أن هناك تداخلاً كبيراً بين القرى السورية واللبنانية على الحدود، حيث يعيش عديد من اللبنانيين في القرى السورية، كما يوجد قرى لبنانية داخل الأراضي السورية ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطرقات السورية. واعتبر القزح أن المشكلة القائمة منذ سقوط نظام الأسد ليست بالدرجة الأولى سياسية، بل ترتبط بصورة أساس بعصابات التهريب التي تعمل في المنطقة. وأكد أن العشائر في تلك المناطق تتبع قوانين خاصة بهم، ولا يهتمون كثيراً بالتنظيمات السياسية، بل تتركز أعمالهم على التهريب والأنشطة غير الشرعية. وأضاف أن هذه الأنشطة بدأت منذ تأسيس الدولة اللبنانية في عام 1920، واستمرت عبر الأجيال في تهريب الممنوعات والأنشطة غير القانونية التي باتت جزءاً من الواقع اليومي على الحدود.
وأوضح القزح أنه نتيجة لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت هذه القرى المشتركة على الحدود بين البلدين. وأضاف أن هذه القرى نشأت بسبب التقسيمات التي تم إقرارها في تلك الفترة، مما أدى إلى تداخل سكاني وجغرافي بين الأراضي اللبنانية والسورية، حيث أصبح من الصعب تحديد الفوارق بين عديد من المناطق بسبب قربها من بعضها البعض وطبيعة الحدود المتشابكة. ونتيجة لهذا التداخل تطورت علاقات بين سكان هذه القرى من الجانبين، مما سهل انسياب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التهريب.
أبرز هذه القرى:
حوش السيد علي: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ500 نسمة، ويحمل جميع سكانها الجنسية اللبنانية.
زيتا: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ1500 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
مطربة: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ800 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
حاويك: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ1200 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
السماقيات: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ700 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
المصرية: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ900 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
الجنطلية: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ600 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
الحمام: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ1000 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
الديابية: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ500 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
بلوزة: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ800 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
النزارية: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ900 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
ربلة: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ1100 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
جزء من العقربية: تقع في محافظة حمص، ويقدر عدد سكانها بـ400 نسمة، ويحمل معظم سكانها الجنسية اللبنانية.
ويقدر العدد الإجمال لسكان هذه القرى بنحو 10,000 نسمة.
أسباب وجود قرى لبنانية داخل الأراضي السورية:
– ترسيم الحدود: لم يكن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا دقيقاً في بعض المناطق، مما أدى إلى وجود قرى لبنانية داخل الأراضي السورية.
– العلاقات الاجتماعية: تربط سكان هذه القرى علاقات اجتماعية قوية مع سكان القرى اللبنانية المجاورة، مما جعلهم يفضلون البقاء في قراهم على رغم وقوعها داخل الأراضي السورية.
– الأراضي الزراعية: يمتلك سكان هذه القرى أراضي زراعية داخل الأراضي السورية، مما يجعل من الصعب عليهم الانتقال إلى لبنان.
————————————————————
الهجرة العكسية كظاهرة اجتماعية في السويد: لماذا يترك العرب دولة الرفاه؟/ سنان السبع
08-02-2025
كانت السويد حتى وقتٍ قريب واحدةً من أكثر الوجهات الأوروبية جذباً للمهاجرين، خاصةً من الدول التي فتكت بها الحروب والصراعات. وقد ساهمت سياسات اللجوء السخية وتاريخ من الترحيب بالمهاجرين في جعلها مقصدًا لآلاف الباحثين عن حياة جديدة وآمنة وكريمة. فوفقًا لتقارير الحكومة السويدية، استقبلت البلاد نحو 163.000 طالب لجوء في عام 2015 وحده، وهو أعلى رقم في تاريخها الحديث. ومع ذلك، شهدت السنوات الخمس الأخيرة تحولًا غير متوقع، إذ بدأت السويد تسجّل «هجرةً عكسية»، إذ يغادر عددٌ متزايدٌ من المهاجرين الحاصلين على الجنسية السويدية، وخاصةً من الدول العربية، الدولةَ الإسكندنافية عائدين إلى أوطانهم الأصلية أو بحثاً عن فرصٍ أفضل في أماكن أخرى من العالم.
صافي الهجرة سالب
تشير الإحصائيات السويدية الرسمية الأحدث إلى أن عدد المغادرين من السويد قد تجاوز عدد الوافدين إليها لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. ففي عام 2023، شهدت السويد صافي هجرة سالب، حيث غادر نحو 5.700 شخص البلاد بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) من ذلك العام، في حين بلغ عدد المهاجرين الجدد 4.900 شخص فقط. على الرغم من أن الهجرة إلى السويد كانت تمثّل حياةً جديدةً للكثيرين، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية أدّت إلى تحوّل تلك الآمال إلى خيبة أمل.
وبحسب موقع Statista المعني بالإحصائيات، شهدت السنة الأخيرة انخفاضاً في عدد اللاجئين القادمين إلى السويد، إذ انخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة 42 بالمئة مقارنةً بالعام الذي سبقه. وتُظهر إحصائياتٌ أخرى أن نحو 22.000 من المهاجرين العائدين، أو حوالي 13 بالمئة من جميع المهاجرين في السنوات الأخيرة، أي بعد العام 2015، قد غادروا البلاد بسبب عدم القدرة على التكيّف مع البيئة السويدية أو الظروف الاقتصادية.
علاوةً على ذلك، أظهرت أرقام هيئة الإحصاء الوطني السويدية أن عدد المهاجرين الذين غادروا البلاد في عام 2022 بلغ 50.592 شخصاً، وشكّل المولودون في السويد من أبوين سويديَيْن نسبة 37 بالمئة منهم، وذلك لأسباب متنوعة. ومع نهاية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 66 ألف شخص مهاجر من السويد (أي أنهم غادروا لأكثر من عام وتمّ شطبهم من سجلات المقيمين)، وهي أرقامٌ «مُقلِقة» تُظهر اتجاهاً متزايداً نحو الهجرة أو ما يمكن تسميته «الهجرة العكسية».
ترافق ذلك مع انخفاض عدد الولادات إلى معدلات غير مسبوقة، مما أدى إلى تراجع النمو السكاني ليصبح الأدنى منذ عام 2001. وهذه الأرقام تعكس القلق المتزايد بين المهاجرين حول الاستقرار في السويد، وتساهم في فهم الأسباب وراء قرار الهجرة العكسية.
السياسة: اللاعب الأساسي في ملف الهجرة
في السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة، بدأت السويد في تطبيق سياسات هجرة أكثر تشدّداً، وذلك بالتزامن مع تصاعد تأثير الأحزاب اليمينية المتطرفة على المشهد السياسي في البلاد. فبعد الانتخابات العامة في عام 2022، حصل حزب «المعتدلين» على السلطة في تحالف مع حزب «الديمقراطيين السويديين» اليميني، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في سياسة الهجرة. وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، صرّحت بفخر أن السويد تسجل الآن «صافي هجرة سلبي» للمرة الأولى منذ عقود، مشيرةً إلى أن الحكومة تهدف إلى السيطرة على تدفق المهاجرين وتقليل أعدادهم.
ومع ذلك، فإن هذه السياسات كانت مثار جدلٍ واسع في المجتمع السويدي. فعلى الرغم من أن الحكومة تدّعي أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين يعتبرون أن هذه السياسات «تؤدّي إلى تهميش الفئات الضعيفة». وتعليقًا على ذلك، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ «التضييق على فرص اللجوء يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية».
أسباب الهجرة العكسية
تتنوع العوامل التي تدفع المهاجرين لمغادرة السويد بين اجتماعية وسياسية واقتصادية. فقد وصلت دراسةٌ مسحية أجرتها جامعة أوبسالا إلى أن 58 بالمئة من المهاجرين الذين غادروا السويد عبّروا عن استيائهم من ظروف العمل، في حين أن 67 بالمئة أشاروا إلى قلّة فرص الاندماج الاجتماعي. كما عزت الدراسةُ تزايد الهجرةَ العكسية إلى الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة، إذ ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 6.6 بالمئة في عام 2023، مما أثّر على القدرة الشرائية للمهاجرين، الذين هم بين أضعف الفئات اقتصادياً. لكنّ رغم ذلك، فإنّ قرابة 45 بالمئة من العائدين لم يعودوا لأسباب اقتصادية فحسب، بل لأنهم افتقدوا الهوية والثقافة، خاصةً مع الاغتراب الذي شعروا به في المجتمع السويدي.
علاوةً على ذلك، يُعبّر العديد من المهاجرين عن شعورهم بالعزلة الاجتماعية، حيث يُعتبر المجتمع السويدي في كثير من الأحيان «منغلقاً» على حدّ وصفهم. يقول كريم العلي، الذي عاد إلى العراق بعد عشر سنوات من الإقامة في السويد: «كنت أطمح لتحقيق أحلامي في السويد، ولكن بعد معاناةٍ من الاغتراب والشعور بعدم الانتماء، أدركت أنه من الصعب الاستمرار. القوانين الجديدة التي قيّدت فرص العمل لم تساعدني على بناء مستقبلي، وعندما عُرضت عليّ فرصة العودة إلى بلدي، كانت الخيار الأفضل بالنسبة لي».
«سحب الأطفال» كسبب للهجرة العكسية
في السنوات الأخيرة، أصبحت القضايا المتعلقة بجهاز الرعاية الاجتماعية (السوسيال) في السويد محور جدل واسع بين الأسر المهاجرة. تشعر العديد من العائلات بالقلق المتزايد حول إمكانية سحب أطفالهم من قبل «السوسيال»، وهو ما يسبب شعوراً بعدم الأمان ويؤثّر بشكلٍ كبير على قرارات الهجرة العكسية. هذا الوضع تفاقم بسبب تصاعد حملات الكراهية ضد المهاجرين، مما جعل العديد من الأسر تشعر بأن «السوسيال» يستهدفهم بشكل خاص، كما ساهمت وسائل إعلام ناطقة بالسويدية أو بلغاتٍ أخرى في تنمية هذا الشعور بالتهديد.
العديد من العائلات المهاجرة فقدت الثقة في النظام، خاصةً بعد ما وصفته بـ«الخروقات» في عمليات سحب الأطفال. يعتقد البعض أن هناك تمييزاً في كيفية تنفيذ هذه العمليات، إذ «يُسحب» الأطفال أحياناً دون التحقق من الأضرار الحقيقية التي قد تلحق بهم. في هذا السياق، قال أحد المهاجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «الخطاب العنصري متصاعد على المستويين الرسمي والمجتمعي، وهذا يشمل أيضاً المؤسسة الاجتماعية. نشعر بالخوف على أطفالنا، ومن أن يتم سحبهم منا حتى في غياب أي مبرر واضح لذلك. هذا الضغط يدفع الكثير من الأسر إلى التفكير في العودة إلى البلدان التي قَدِمت منها في حال استقرارها الأمني والسياسي والخدمي».
هذه القضايا أصبحت أكثر وضوحًا بعد انتشار وسم «أوقفوا خطف أطفالنا» على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى خروج مظاهرات في العاصمة ستوكهولم في شباط (فبراير) الماضي. رفع المحتجون صور أطفالهم، وردّدوا هتافات مثل «أوقفوا خطف أولادنا» و«العدالة من أجل أطفالنا»، وهذه المظاهرات ليست إلا استمراراً لمظاهرات ما انفكت تخرج بين حين وآخر طوال العامين الماضيين. ورغم التصعيد الأخير، نفت الحكومة السويدية الاتهامات الموجهة إليها من الأسر، ولم تعلّق على المظاهرات.
وفقًا للقانون السويدي الذي تم إقراره في السبعينات، يحق لمؤسسة «سوسيال» انتزاع الأطفال من أسرهم إذا ثبتَ وجود تجاوزات تُمارس ضدهم، مثل العنف أو عدم القدرة على توفير الأساسيات التي يحتاجها الطفل. وبموجب هذا القانون، يمكن سحب جميع أطفال العائلة إذا تعرّض أحدهم لظروفٍ تعتبرها المؤسسة غير مناسبة. لكن العديد من المهاجرين يعتقدون أن «سوسيال» تنفّذ عمليات السحب بشكل غير عادل، ويشتكون من أن الأطفال يتم سحبهم «بناءً على مزاعم غير صحيحة»، الأمر الذي يزيد من تعميق الفجوة بين المجتمع السويدي والمهاجرين.
وفي هذا السياق، ذكر محقق سابق في «سوسيال» أنه عمل في هذا المجال لمدة عشر سنوات وشهد العديد من الانتهاكات التي أدت إلى استقالته، وأوضح أن هذه الانتهاكات تتضمّن تحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر بهدف إتمام عملية السحب، مشيراً إلى شبهات فساد يصعب توثيقها بسبب غياب الرقابة على الموظفين الإداريين. كما أشار إلى أن بعض الأسر البديلة التي تحتضن الأطفال تتقاضى أموالًا ضخمة مقابل ذلك، ما حول المسألة إلى «ما يشبه التجارة» على حدّ وصفه.
على الرغم من هذه الاتهامات، أكدت الحكومة السويدية عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أنه «يحق لجميع الأطفال في السويد التمتّع بطفولة آمنة»، مشيرةً إلى أنّ الدولة لا تسعى إلى فصل الأطفال عن أسرهم «إلا إذا كان هناك خطر حقيقي على الطفل». وأضافت أن القرار النهائي بشأن الأطفال لا يتم اتخاذه من قبل «سوسيال»، وإنما من قبل القضاء، مع الإشارة إلى أن هناك حالات يعود فيها الأطفال إلى أسرهم.
ومع ذلك، أكدت الحقوقية المتخصصة في حقوق الأطفال د.ماريتا هولمبيرغ في حديثها للجمهورية.نت «وجود خروقاتٍ في نظام سوسيال وأن الأموال التي تُدفع للأسر البديلة تعتبر مصدراً للانتفاع غير المشروع». كما أشارت إلى أن بعض الأسر البديلة «تتقاضى ما يصل إلى 7 آلاف دولار شهرياً مقابل كل طفل يتم احتضانه، ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتّبعة في عملية سحب الأطفال».
أما فيما يتعلق بالشهادات من الأسر المتضررة، فقد تحدث العديد من الآباء عن تجاربهم مع «سوسيال». قال لنا أحد الآباء (فضّل عدم ذكر اسمه)، وهو أب لسبعة أطفال، إن ابنته تم سحبها بعد أن كتبت صديقاتها رسالة إلى المعلمة في الفصل حول مزاعم تعنيفها في المنزل. وأضاف أن سحب ابنته تم بناء على مزاعم غير صحيحة، حيث تم التحقيق مع باقي أولاده، لذا «اضطُروا إلى الهروب من السويد لتجنب فصل باقي الأطفال عنهم»، ولم يُتح لنا سماع رد السوسيال على مزاعم الأب. مهاجرٌ آخر التقيناه تحدّث عن سحب ابنته من قبل «سوسيال» بعد شجار مع إحدى زميلاتها في المدرسة، مشيرًا إلى أنه «كان متهماً بالعنف، رغم أن الاتهام لم يكن دقيقاً، وأنه لم يتمكن من استعادة ابنته منذ ذلك الحين» على حدّ ادعائه.
وفي ما يخص الإحصائيات، ذكر تقرير صادر عن «سوسيال» أن عدد الأطفال الذين خضعوا للرعاية في عام 2020 بلغ 27 ألفًا و300 طفل-ة، تم وضع 19 ألفاً منهم لدى عائلات بديلة و8300 في دور رعاية، حيث كانت النسبة الأكبر من الأطفال الذكور (58 بالمئة) مقارنةً بالإناث (42 بالمئة).
إجمالًا، تعكس هذه القضية العديد من التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة في السويد، بما في ذلك الشعور بالعزلة، وفقدان الثقة في النظام الاجتماعي، واتخاذ قرارات مؤلمة بالعودة إلى أوطانهم الأصلية.
ردّت الحكومة السويدية رسمياً على الاتهامات الموجهة لها بشأن سحب الأطفال، أبناء العائلات المسلمة على وجه الخصوص، من عائلاتهم، مؤكدةً أن التقارير التي تحدّثت عن هذه الظاهرة «غير صحيحة». وفقاً للأرقام الرسمية، بحسب الحكومة، لا توجد «زيادة غير مُبرّرة» في حالات سحب الأطفال من العائلات المسلمة، كما أن إجراءات السوسيال تتم بناءً على مصلحة الطفل دون تمييز ديني أو ثقافي. الحكومة شددت على أنها تلتزم بحقوق الإنسان وتستند إلى قوانين راسخة لحماية الأطفال من جميع الأوساط الاجتماعية.
مقترحات حكومية لتشجيع «العودة الطوعية»
لم تكتفِ الحكومة السويدية بتقليل أعداد المهاجرين من خلال القوانين الصارمة فقط، بل تسعى أيضاً لتشجيع العودة الطوعية من خلال تقديم حوافز مالية. وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وزارة الهجرة السويدية «قد تُقدّم الحكومة حوافز تصل إلى 350.000 كرون سويدي (حوالي 32.000 يورو) للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم. ومع ذلك، واجهت هذه الخطة انتقاداتٍ واسعة، إذ يعتبر البعض أن تقديم الأموال لا يعالج الأسباب الجذرية التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة السويد.
تأثير الهجرة العكسية على المجتمع السويدي
يُشكّل ارتفاع معدلات الهجرة العكسية تحدياً كبيراً للحكومة السويدية. من جهة، تُعتبر الهجرة العكسية بمثابة إشارة إلى نجاح السياسات الصارمة في تقليل تدفق المهاجرين. لكن من جهةٍ أخرى، يتساءل البعض عما إذا كانت هذه السياسات ستُفضي إلى فقدان المواهب والكفاءات التي تحتاجها السويد. تشير التقارير إلى أن العديد من المهاجرين يعودون إلى بلدانهم بسبب فقدان الأمل في الحصول على حياة أفضل، وأفادت دراسةٌ صدرت مؤخراً إلى أنّ 72 بالمئة من العائدين «قالوا إنهم لم يشعروا بأنهم جزء من المجتمع السويدي».
لماذا تركت السويد؟
طرحنا هذا السؤال على مجموعةٍ من الأشخاص، جميعهم ولدوا في بلدان عربية وانتقلوا للسويد لأسباب مختلفة، ثم تركوها نحو بلدانهم أو نحو بلدٍ ثالث. يمكن من خلال قراءة إجاباتهم، وتنوّع أسبابهم الحصول على عددٍ ليس قليل من الأسباب، تتقاطع كثيراً، ولكنها تعكس مدى أهمية التجربة الشخصية في اتخاذ قرار ترك واحدةٍ من الدول الأكثر استقراراً ورخاءً في العالم.
سارة الأحمد- الوجهة: دبي
«الأسباب الرئيسية لمغادرتي السويد هي الشعور بالوحدة والعزلة. عشت هناك لمدة خمس سنوات، لكنني شعرت أنني لا أستطيع التكيف مع ثقافة المجتمع المحلي. إضافةً إلى ذلك، كان لدي فرصة عمل أفضل في دبي. تجربتي كانت مختلطة. في البداية كان الأمر رائعًا، ولكن مع مرور الوقت واجهتُ تحدياتٍ كبيرةً في الاندماج. صعوبة تعلّم اللغة وتكوين صداقات جديدة كانا من أكبر التحديات. كما أن تكاليف المعيشة كانت مرتفعةً جداً، مما جعل الأمور أصعب. الحياة في دبي أكثر حيويةً وتنوعاً. في دبي أشعر أنني جزءٌ من المجتمع، ويمكنني التواصل بسهولة مع الآخرين. أما في السويد، فقد شعرت دائماً أنني غريبة، حتى بعد سنوات من الإقامة. أكبر صعوبة كانت التكيف مرةً أخرى مع نمط الحياة في دبي. بعد فترة من العزلة في السويد، كان من الصعب إعادة بناء شبكة علاقاتي الاجتماعية. ولكن بمرور الوقت، بدأت أستعيد اتّصالي بأصدقائي وعائلتي».
سمير أحمد- الوجهة: العراق
«السبب الرئيسي لمغادرتي السويد كان صعوبة التكيف مع الحياة هناك. بعد عامين من المحاولة، شعرت أنني لم أستطع العثور على فرصة عمل تناسب مهاراتي، وكانت الحياة اليومية صعبة للغاية. كانت تجربتي مليئة بالتحديات. شعرت بالانفصال عن عائلتي وأصدقائي، وواجهت صعوبةً في العثور على وظيفة مناسبة لي. اللغة كانت عقبة كبيرة، حيث لم أتمكن من التحدث بها بطلاقة، مما جعل الاندماج صعباً. الحياة في العراق أكثر حميمية وارتباطًا بالعائلة. رغم التحديات، أشعر أنني في مكانٍ أفضل، حيث يمكنني التواصل مع مَن حولي بسهولة. السويد كانت رائعة من حيث الحقوق الاجتماعية، لكنني شعرت بالفقدان في العلاقات الإنسانية. أكبر صعوبةٍ أواجهها حالياً هي إعادة التكيف مع الحياة في العراق. الأمور قد تكون مختلفة، ولكنني افتقدت القيم الثقافية والروابط الأسرية التي عشتها قبل مغادرتي نحو السويد».
محمد سعد- الوجهة: مصر
«أسباب مغادرتي للسويد كانت متعددة، بما في ذلك الشعور بعدم الانتماء والإحباط من قيود سوق العمل. لم أتمكن من العثور على عملٍ يناسب مهاراتي، مما جعلني أفكر في العودة. التجربة كانت صعبة. بينما كانت السويد توفّر جودة حياةٍ أعلى، كنت أواجه صعوباتٍ في التكيف مع الثقافة الجديدة. كما أن الشتاء القاسي كان مؤثراً جداً على المستوى النفسي. شعرتُ بالانفصال عن عائلتي وأصدقائي. في مصر، أشعر بالقدرة على التواصل مع الناس وبسهولة تكوين العلاقات. السويد كانت رائعةً في بعض الجوانب، لكنها كانت غريبةً بالنسبة لي. هنا في مصر، أستطيع التواصل بسهولة مع عائلتي وأصدقائي. أكبر صعوبة كانت التكيف مع الوضع الاقتصادي المتغير في مصر. رغم أنني عدت إلى بلدي، لكنني شعرت ببعض القلق حيال المستقبل الوظيفي».
أحمد علي- الوجهة: العراق
«أسهم الخطاب العنصري المتزايد في السويد بجعلي أشعر بعدم الارتياح. كنت أعيش في قلقٍ دائمٍ حول مكانتي هناك، وهذا دفعني للتفكير في العودة. تجربتي كانت صعبة. بالرغم من أنني حصلت على الجنسية، فإن شعوري بأنني غريب في بلدي الجديد كان يرافقني دائماً. كانت هناك تحديات اقتصادية وصعوبات في العثور على عمل مناسب. الحياة في العراق تُعطي شعوراً بالانتماء والهوية. بينما كانت السويد تمنحني فرصة عيش حياة كريمة، إلا أنني كنت أشعر بعدم الراحة وعدم الانتماء. بعد العودة، كان عليّ التكيف مع وضع العراق، الذي يختلف تمامًا عن السويد. الأوضاع الاقتصادية والتحديات الأمنية كانت صعبة، لكنني شعرت بالراحة لكوني في بلدي».
العمل، والأسرة، والعزلة الاجتماعية، جميعها أسباب لترك السويد
من خلال مقابلاتٍ أخرى، تتكشف أبعاد جديدة تدفع المهاجرين للعودة إلى أوطانهم الأصلية، و نصل إلى شهادات وأسباب متنوعة لهذه الظاهرة، تشمل تحديات سوق العمل المغلق، والخوف من تأثير السياسات الاجتماعية، والشعور بالعزلة في مجتمع يفتقد الدفء الاجتماعي. هذه الشهادات تسلّط الضوء على الجانب الإنساني العميق وراء هذه القرارات المصيرية، وتكشف النقاط التي تجعل العودة خياراً حتمياً لبعض العائلات والأفراد.
«العودة إلى العراق فتحت لي أبواباً لم أجدها في السويد»، بهذه الكلمات يلخّص الصحفي عامر محسن قراره بالعودة إلى بلده الأم. على الرغم من حصوله على الجنسية السويدية وسنواتٍ من تطوير مهاراته اللغوية والمهنية، وجد أن العمل في مجال الإعلام في السويد مغلق أمام المهاجرين. يشرح عامر تجربته قائلاً: «توفّر السويد حريةً إعلاميةً كبيرة، لكنّ سوق العمل في الإعلام يشبه النادي المغلق الذي يصعُب على المهاجرين اختراقه. بذلت كل ما في وسعي، لكنني شعرت بالإحباط المتزايد مع كل محاولة غير ناجحة. عندما عدت إلى العراق، كان هناك تحدٍ جديد، لكنه فرصة كذلك. تمكنت من العمل مع مؤسساتٍ إعلامية، ووجدت بيئةً تناسب طموحاتي المهنية. لقد كانت خطوةً صعبة، لكنها الخيار الصحيح لاستعادة مسيرتي المهنية والشعور بالقدرة على تحقيق أهدافي».
أما صادق عبد الله، وهو رب أسرة عاد إلى العراق مع زوجته وابنتيه، فكان قراره بالعودة متعلقاً بالأسرة والأمان. يقول صادق: «عشتُ مع عائلتي في السويد لسنوات، وأحببنا الكثير من الجوانب هناك، لكنّ الخوف كان يرافقنا دائماً. القوانين المتعلقة بدائرة السوسيال، رغم أنها تبدو مصممةً لحماية الأطفال، سبّبت قلقاً كبيراً لي كأب. كنت أخشى أن يسيء أحدٌ تفسير ‘اختلافاتنا الثقافية’، فيؤدي ذلك إلى تدخّل الدولة في حياتنا الأسرية. هذه المخاوف لم تجعلني أشعر بالأمان حتى في دولة متقدمة مثل السويد. عدنا إلى العراق حيث نعيش بين الأهل والأصدقاء، وعلى الرغم من التحديات، أشعر أنني أملك السيطرة على حياة أطفالي ومستقبلهم في ظل قيمنا وثقافتنا».
من جهتها، عادت ليلى إبراهيم مع عائلتها إلى دبي بعد سبع سنوات من الحياة في السويد. تصف ليلى تجربتها قائلةً: «كانت السويد مختلفةً جداً عما توقعت. الجو البارد والمظلم كان يؤثر على حالتي النفسية بشكل كبير، لكن الأمر لم يكن مقتصراً على الطقس فقط. الحياة الاجتماعية هناك تكاد تكون معدومة؛ شعرت بأننا كعائلة نعيش في عزلة تامة، بلا روابط أو تفاعل حقيقي مع الآخرين. حتى محاولاتنا للاندماج كانت تصطدم بحواجز الثقافة واللغة. زاد الأمر سوءاً مع تصاعد الخطاب العنصري في السياسة السويدية، خاصةً من قبل الأحزاب اليمينية، ما جعلني أشعر أننا لسنا مرحباً بنا. العودة إلى دبي كانت خطوة استعدنا من خلالها حياتنا الاجتماعية النشطة وأسلوب حياة يشعرنا بالدفء، سواء على المستوى الإنساني أو العائلي. اليوم، أستطيع أن أقول إنني أشعر بالراحة أخيرًا».
تعكس هذه الشهادات الهواجس الإنسانية المُعقّدة التي يواجهها المهاجرون في السويد، من العوائق المهنية إلى مخاوف الأسرة وصولاً إلى الشعور بالعزلة الاجتماعية. وبجمع هذه الأصوات، يصبح من الواضح أن القرارات المتعلقة بالهجرة العكسية ليست مجرد رد فعل على الظروف المادية، بل هي عملية معقدة تتأثر بالعوامل الثقافية والنفسية والاجتماعية. هذه الشهادات تضيف بعدًا عميقًا لفهم هذه الظاهرة وأثرها على المجتمعات المهاجرة والمستقبلة.
المشهد السياسي الحالي في السويد
تعيش السويد حالياً فترةً من التغيرات السياسية الكبرى، بعد أن تمكنت الحكومة من تقليل أعداد المهاجرين والوصول إلى صافي سلبي للهجرة، وهو أمرٌ يُعتبر إنجازاً كبيراً في نظر العديد من السياسيين. تحت قيادة وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرجارد، تبنّت الحكومة مجموعةً من السياسات الهادفة إلى تقليل تدفّق المهاجرين، حيث أكدت في عدة مناسبات أن هذه الخطوات «ضرورية للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد».
في تصريحاتها الأخيرة، أعربت مالمر ستينرجارد عن سعادتها بإنجاز الحكومة في «تقليص أعداد المهاجرين»، مشيرةً إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الجديدة في خلق بيئة أفضل للمواطنين السويديين. صرحت كذلك بأنّ «الوصول إلى صافي هجرة سلبي يُعدُّ علامةً على أننا نعمل على تعزيز الأمان والاستقرار في مجتمعنا». وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس، إذ يزداد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تنادي بتقليل أعداد المهاجرين وتضييق الخناق على سياسة اللجوء.
علاوةً على ذلك، أعرب العديد من المسؤولين الحكوميين عن ارتياحهم لهذا الاتجاه، معتبرين أن الانخفاض في أعداد المهاجرين سيُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة ويخفف من الضغط على الموارد. ففي تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء أولف كريستيرسون، أكد على أن هذه الخطوات «تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الشعب السويدي». وبشكلٍ عام، تبدو الحكومة السويدية متفائلةً بشأن مستقبل البلاد بعد اتخاذ هذه الإجراءات، مع تأكيدها على «ضرورة التركيز على قضايا الأمن والاندماج».
حملات «تبشيرية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي
انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعواتٌ تُروج لفكرة العودة إلى الوطن تحت شعار «عودوا إلى الجذور»، تُشجّع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرةً إلى الأوضاع المعيشية الجيدة التي قد يوفرها الوطن. تتبنّى هذه الحملات أسلوباً يدعو إلى العودة للهوية الأصلية والتواصل مع الثقافة الأم، بينما تتزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المهاجرون، مما يجعل هذه الحملات تحظى بمتابعةٍ واهتمامٍ كبيرين. ينظر بعض المهاجرين إلى هذه الحملات كفرصة لاستعادة الروابط الثقافية والاجتماعية التي فقدوها في الغربة، حيث يعتقدون أن العودة إلى الوطن قد تكون الحل الأمثل لتخفيف معاناتهم النفسية والتواصل مع بيئة أكثر دفئاً وإنسانيةً.
العديد من الشخصيات العامة على منصات التواصل الاجتماعي بدأت تشارك تجاربها الشخصية المتعلقة بالعودة إلى الوطن، مما جعل هذه الحملات تزداد قوة وانتشاراً. إحدى الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في هذا السياق هي الفتاة سمانة، التي تمتلك أكثر من مئة ألف متابع على منصة تيك توك. سمانة، التي انتقلت مؤخراً من السويد إلى دبي، بدأت في نشر فيديوهات تشرح أسباب انتقالها إلى الإمارات، وهو ما جذب الكثير من النقاشات والمتابعات.
في أحد الفيديوهات التي نشرتها على حسابها في تيك توك، تحدثت سمانة عن الأسباب التي دفعتها للانتقال إلى دبي، وقالت إن القرار كان مدفوعاً بعدة عوامل. أولاً، أشارت إلى أنها «تفضّل الطقس الحار في دبي على المناخ البارد في السويد، معتبرةً أن الأجواء المشمسة تمنحها شعوراً أفضل». كما أكدت سمانة أن «عدم وجود ضرائب في دبي كان من العوامل المهمة التي شجعتها على الانتقال»، حيث ترى أن هذا يتيح لها الفرصة لتوفير المزيد من المال. وأضافت أن الحياة الاجتماعية في الدول العربية، بما في ذلك دبي، أفضل بكثير مقارنةً بالدول الأوروبية، حيث «تجدها أكثر ترابطاً وقرباً».
وتابعت سمانة أنها تجد في دبي رفاهيةً عالية، مشيرةً إلى أن تكلفة الخدمات منخفضة وأنها قادرة على الحصول على كل ما تحتاجه بسهولة من خلال التطبيقات المتوفرة على الإنترنت. كما تحدثت عن فرص العمل المتنوعة التي توفّرها دبي، معتبرةً أن السوق هناك يسمح لها بالعمل في أكثر من مهنة خلال اليوم. وأخيراً، قالت سمانة إن تربية الأطفال في دبي أسهل وأكثر راحة حيث «يوجد قانون صارم في الإمارات تستطيع من خلال السيطرة على أطفالها، عكس ما هو موجود في أوروبا، مما يجعلها تشعر بأن بيئة دبي أكثر ملائمة لنشأة أطفالها».
هذا التصريح يعكس بعض الأسباب التي دفعت سمانة لاتخاذ قرارها بالانتقال إلى دبي، ويُظهر كيف أن بعض المهاجرين يجدون في العودة إلى دول المنطقة أو الانتقال إليها «مميزات تتناسب مع نمط حياتهم».
أما آية عبد، هي صانعة محتوى تمتلك أكثر من نصف مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت قد عاشت سابقاً في دبي وهي الآن في السويد، فقد ردّت على سؤال حول ميزات دبي والسويد قائلة: «نظام السكن في دبي أسهل بكثير مقارنة بما هو موجود في السويد. في دبي، يمكنني ببساطة الذهاب إلى أحد المكاتب المتخصصة والحصول على سكن بسهولة، بينما في السويد يتطلب الأمر الانتظار لعدة سنوات للحصول على سكن مناسب». وأضافت: «أما الطقس، فهو شديد البرودة في السويد خلال فصل الشتاء، بينما في دبي يكون الطقس معتدلاً ومريحاً، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة».
الأمر لا يقتصر على السويد وحدها من حيث تأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمتد ليشمل الدول الأوروبية الأخرى. عصام سعيد هو شاب فلسطيني متخصص في العملات الرقمية ولديه أكثر من 10 آلاف متابع على منصات التواصل الاجتماعي، نشر فيديو على منصة إنستغرام حصد أكثر من مليون مشاهدة، قال فيه: «حين عشت لفترة شهر في دبي، عدت للعيش في بلجيكا لكن لم أعد أستطيع العيش هنا كما كنت سابقًا. الملل في بلجيكا غير طبيعي. بدأت أكتشف كم أن قوانين أوروبا غبية، خصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية. حتى التكنولوجيا في دبي متقدمة على أوروبا بعشر سنوات. هذا غير عقلية الناس الذين يعيشون هنا مقارنة بدبي. بصراحة، لا أستطيع العودة للعيش في بلجيكا.
مع أن بلجيكا بلد جميل جداً ومتقدم، ومن أنجح دول العالم، وقد عشت هنا لمدة 11 سنة ورأيت تطور البلد كل أربع أو خمس سنوات، إلا أن الوضع في دبي مختلف. في شهر واحد في دبي، أنجزت في مجال الأعمال ما لم أتمكن من إنجازه في سنة كاملة هنا في بلجيكا. ولهذا قررت أن أذهب وأعيش في دبي».
تمثّل العودة العكسية للمهاجرين تحوّلاً كبيراً في الساحة السويدية، ويبدو أن المستقبل سيشهد مزيداً من التحديات، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. تعكس تجارب الأشخاص الذين تحدّثنا إليهم عمقَ المعاناة التي قد يواجهها المهاجرون، وتسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير سياسات هجرة أكثر شموليةً وتضمن فرصاً متكافئةً للجميع. ينبغي أن تكون هذه السياسات مرتبطة بالتواصل الفعّال بين الثقافات، وضمان فرص العمل والاندماج، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمهاجرين في السويد.
* * * * *
سنان السبع إعلامي وكاتب عراقي مقيم في السويد. يعمل مراسلاً لقناة الرابعة العراقية وكاتباً في جريدة الصباح، ويغطي القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق والسويد.
أُنتج هذا المقال ضمن زمالة «الصُنعة» الصحفية، والتي أُقيمت بالتعاون بين الجمهورية.نت وشبكة فبراير.
موقع الجمهورية
—————————————————–
المعارضة الفعّالة هي توأم الديمقراطية الحقيقية/ جمال قارصلي
2025.02.08
في الأنظمة الديمقراطية يُولى اهتمام كبير لدور المعارضة السياسية، ويُرسخ ذلك بشكل واضح وجلي في دستور البلاد, ويُعترف بدورها كجزء لا يتجزأ من العمل السياسي، فهي تسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز النقاشات العامة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها.
ولكن في المقابل، تعاني المعارضة في الأنظمة الدكتاتورية من قيود شديدة، وقد تتحول إلى أداة شكلية يتم توظيفها لتجميل صورة الحاكم أمام المواطنين والعالم الخارجي.
أفضل مثال على ذلك هو المعارضة السورية خلال عهد نظام الأسد البائد, الأب والابن، حيث أصبحت بعض أطراف المعارضة أكثر انقيادًا ومحاباة وتلفيقًا للدكتاتور من حزب البعث نفسه، مما أفقدها مصداقيتها. بدلًا من أن تكون صوت الشعب والمطالبين بالحرية، تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة مُدجنة تخدم النظام الدكتاتوري. هذا الانحراف أفقد المعارضة شعبيتها وأضعف دورها الرقابي والتنافسي، مما أسهم في ترسيخ الديكتاتورية وقمع الحريات.
رغم الدور الحيوي للمعارضة، تعاني النظم السياسية في العالم العربي والشرقي من تحديات كبيرة فيما يتعلق بتقبل النقد. في كثير من الأحيان، يُنظر إلى النقد على أنه هجوم شخصي يستهدف صاحب الفكرة بدلًا من التركيز على مضمونها. هذا التصور يعيق الحوار السياسي البنّاء ويَئِد الأفكار النيّرة ويؤدي إلى تشنجات سياسية تعطل مسيرة التنمية.
على النقيض من ذلك، في الديمقراطيات الغربية، كما تعلمت من خلال عملي السياسي في ألمانيا، يُعتبر النقد فرصة لتطوير الأفكار وتحسين الأداء. هذا الفهم للنقد يعزز ثقافة الحوار البنّاء ويضمن أن تكون المعارضة عنصرًا إيجابيًا يدفع بالعمل السياسي نحو الأفضل.
فوائد ودور المعارضة في العمل السياسي
1. الدور الرقابي على السلطة التنفيذية:
يُعتبر الدور الرقابي من أهم أدوار المعارضة، إذ تعمل كعين يقظة تراقب أداء الحكومة والأجهزة التنفيذية. هذا الدور لا يقتصر على كشف الأخطاء فحسب، بل يمتد إلى تقديم حلول بديلة وتصحيح المسار عند الحاجة. فالمعارضة القوية تقلل من احتمالات تفشي الفساد وتعزز النزاهة في إدارة الشأن العام.
2. تحفيز تطوير الأفكار والمشاريع:
المعارضة ليست مجرد قوة معارضة لكل شيء، بل هي محفز لتطوير السياسات والأفكار. وجود طرف سياسي ينافس الحكومة يدفعها إلى تحسين برامجها وسياساتها لتلبية تطلعات المواطنين. في هذا السياق، تتحول المعارضة إلى شريك فعلي في تحسين الأداء السياسي حتى وإن كانت خارج السلطة.
3. تعزيز التنافس السياسي:
التنافس هو جوهر الديمقراطية، والمعارضة تسهم في ضخ حيوية جديدة في المشهد السياسي من خلال تقديم بدائل وأفكار مبتكرة. هذا التنافس يتيح للناخبين فرصة الاختيار بين برامج متعددة، ما يدفع الأحزاب إلى العمل بجدية أكبر لتقديم الأفضل.
4. حماية وتحسين المصلحة العامة:
تسعى المعارضة إلى تمثيل شريحة واسعة من المجتمع والدفاع عن مصالحها. هذا الدور يحمي التنوع في السياسات العامة ويمنع تغوّل رؤية واحدة على حساب مصالح بقية الأطراف. التمثيل السياسي المتنوع يضمن أن تأخذ الدولة قرارات أكثر شمولية تخدم مختلف مكونات المجتمع.
5. ورقة قوة في التعامل مع المجتمع الدولي:
تلعب المعارضة دورًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية أيضًا، إذ يمكن استخدامها كذريعة من قبل الدول لتجنب الانصياع لبعض المطالب الدولية. على سبيل المثال، يمكن أن تبرر الحكومة رفضها لبعض الشروط الدولية بوجود معارضة داخلية قوية تعارض تلك الشروط، مما يعزز موقفها التفاوضي ويمنحها هامشًا أوسع للحركة.
6. تعزيز الشفافية في إدارة البلاد:
المعارضة تسلط الضوء على الأداء الحكومي وتدفع باتجاه المزيد من الشفافية. هذا الدور الرقابي يسهم في تحسين التواصل بين الحكومة والشعب، كما يسمح للرأي العام بالحصول على صورة أوضح عن السياسات العامة.
تلعب المعارضة دورًا أساسيًا في تعزيز الديمقراطية وتحسين الأداء السياسي من خلال الرقابة والتنافس وتحفيز الأفكار. مع ذلك، تحتاج الثقافة السياسية في السياقات الشرقية إلى تطوير لفهم النقد بوصفه فرصة للتحسين وليس هجومًا شخصيًا.
من دون معارضة حقيقية وفعّالة، تفقد الدولة توازنها السياسي وقدرتها على التقدم. لذا، فإن تعزيز دور المعارضة وتمكينها من أداء مهامها بشفافية وحرية يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وهو الحصن المنيع ضد استفحال الديكتاتوريات التي أصبح بعضها يُطلق عليه أوصاف تشابه الأوصاف الإلهية. الديمقراطية الحقيقية هي توأم المعارضة الفعّالة، وهي التي توصل الحاكم إلى السلطة وتشكل الجوهر الذي يرتكز عليه مبدأ تداول السلطة
تلفزيون سوريا
————————————-
أعلنا النصر.. لنعلن تأسيسَ الجديد/ مضر رياض الدبس
2025.02.08
لنتأمل معًا الجملة الآتية وكأنها مقدمةٌ تأسيسيةٌ للجديد الذي نحن بصدده:
نحن الشعب السوري، نُقرُّ أن كلَّ إنسانٍ فِينا له الحقُّ في الحياة، والكرامة، والحرية، والسعادة.
بعد هذا التأمل، لنبدأ النقاش الآتي: إن سورية منتصرةٌ، أمرٌ لا يشك به أحد، وبعد جملة القرارات التي اتخذها مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني لم نعد بحاجة إلى شيٍء آخر لنقول إن سورية قد انتصرت على الهمجية التي بناها نظام الأسد وحلفاؤه. والآن، بدأت المرحلة الأولى في تاريخنا الراهن، ويبدو أنها مرحلةُ تثبيت سرديةٍ وطنيةٍ كبرى، وإعلان بداية تنفيذها، ثم ترجمتها إلى سياساتٍ عملية. ومهمٌ أن يتم اقتراح هذه السردية من روح الشعب السوري المعاصرة، ونياته، وأحلامه، وتطلعاته؛ وأيضًا من عصارة تجربة السوريين في التاريخ منذ المؤتمر السوري العام، وإعلان الاستقلال الأول عام 1920، مرورًا بـ “إعلان الاستقلال الثاني” عام 1941، والاستقلال عام 1946، مرورًا بانقلاب 1963 الذي أخرجنا من نادي الإنسانية، ثم انقلاب 1970 الذي أوقف التاريخ في هذا البلد، وصولًا إلى لحظة الـ 2011 المباركة، وأخيرًا إلى الثامن من كانون الأول عام 2024، يوم عودتنا إلى نادي الإنسانية.
إذًا، نحن أعلنا سورية منتصرةً، ولكن ظلَّ أن نعلن سورية جديدة: أي أن نعلن السردية الوطنية السورية التأسيسية الأخلاقية القانونية؛ فالجديد اليوم مفهومٌ يبنيه السوريون بالضرورة على سردية مُؤَسِّسَة للشعب السوري. والشيء الجديد يعني في العمق أن نسكن سوريا سياسيًا، ونحن، إلى الآن، نسكن سورية محليًا، وعصبويًا: قبائليًا، وطائفيًا، وإثنيًا، وأيديولوجيًا، وأخيرًا فصائليًا (يبدو أن المشهد الفصائلي بدأ بطريق الاختفاء)؛ وهذه السُكنى لا تجعل من سورية وطنًا، بل تجعل منها حلبة لـ “حرب الكل ضد الكل”.
النصر الآن بالفعل كما قال الشرع: “حملٌ ثقيل، ومسؤولية عظيمة”، وهذا صحيحٌ لأن المنتصر مسؤولٌ عن ابتكار سورية الجديدة، وهذه مهمةٌ تاريخية وأخلاقية وسياسية كبيرة. المنتصر هو الشعب السوري كله، ممثلًا بسلطةٍ لها شرعية ثورية للمرحلة الانتقالية.
استنادًا إلى ذلك نطرح أن يؤسس هذا الجديد على المبادئ الآتية، التي نرى أنها قابلةٌ لتكون موضع إجماعٍ وطني؛ فيتم طرحها بوصفها سرديةً سوريةً جديدةً كُبرى، ونقترحها كالآتي:
نحن الشعب السوري، نقر أن كل إنسانٍ فينا له الحق في الحياة، والكرامة، والحرية، والسعادة.
في الآتي، نتناول هذه الجملة التأسيسية بشرحٍ كثيف.
أولًا: نحن الشعب السوري:
دائمًا في المجتمع السياسي لا يوجد إلا “نحن” واحدة، هي “نحن الشعب”. لأن الذي يسكن سورية سياسيًا، هو الشعب، والشعب مفهومٌ سياسي بالضرورة. هذا لا يعني إنكار الانتماءات السورية الفرعية أيًا كان نوعها، بل يعني الاعتزاز بها، ودعمها، والاعتداد بوجودها، ولكن على مستوى المجتمع المدني: مجال الصراعات الحميدة، أما المجتمع السياسي، مجال الدولة، فهو مجال الوحدة، الذي ندخله بوصفنا مواطنين أحرار: “نحن المواطنين الأحرار” يساوي ويعادل “نحن الشعب”.
ثانيًا: الحق في الحياة والكرامة:
وهذا يتضمن الآتي بوجهٍ عام:
1) الحق في الأمان والحياة الآمنة:
حقُ الحياة، والعيش بأمان، مضمونٌ لكل فردٍ سوري. ومن واجب كل سلطة في سورية أن تعمل كل ما بوسعها لحفظ هذا الحق، وأن تكون مسؤولةً عن حفظ حيوات السوريين، وأمنهم.
2) الدولة السورية مسؤولةٌ عن حق الحياة، وحق العيش بأمان، مسؤوليةً كاملةً وتامةً. والسلم الدائم هو الغاية الأولى لوجود الدولة السورية وأحد أهدافها السامية.
3) كل سوري هو غاية بحد ذاته، وليس وسيلة لغايات الآخرين:
كرامة السوري مُصانة، يعني أنه غايةٌ في ذاته، ولا يمكن تصوُّره أو التعامل معه بوصفه وسيلةً لغايات شخصية، أو أيديولوجية، أو غيرها.
4) الحق في الدفاع:
من حق أي سوري أن تدافع عنه بلده: تدافع عن أمنه ضد أي تهديدٍ خارجي، وتدافع عن أمنه ضد أي تهديدٍ داخلي، وأيضًا تضمن حقه في طلب الدفاع القانوني إذا كان متهمًا.
5) صون الحريات:
سواء من تغول السلطة السياسية، أو السلطات الاجتماعية، وغيرها؛ فمن حق السوري أن يبني رأيه ويعبر عنه، ليكون مُكرمًا.
6) حق الملكية:
كل سوري له حق في ملكية الشأن العمومي، والعملية السياسية، وملكية الدولة، ومن ثم ترتبط كرامته بالمشاركة في تدبير هذه الملكية المشتركة بصورة تشاركية عمومية، والحفاظ عليها بأفضل صورة.
7) صون الكرامة الوطنية:
يؤسس معنى الكرامة على قاعدة أخلاقية تشاركية تنتمي لفضاء عمومي سوري، بقدر ما يمدنا بالشعور بالأمان، والانتماء، بقدر ما يمدنا بالشعور بالمشاركة في السلطة، والسيادة، والسيطرة، والحصانة تجاه السلطة، والفخر، وغيرها من المفهومات التي تجعل الفرد يشعر بكرامته ويعتز بها، فيجد ما يكفي من القدرة للتركيز في طرائق تحقيق الرفاه والسعادة.
ثالثًا: الحق في الحرية:
ويتضمن الآتي:
1) مفهوم التمكين:
تمكين السوري من أن يكون حرًا، فالأكثر قدرةً أكثرُ حريةً، وهذا يعني:
أ) السعي الدائم إلى ضمان تعليم ممتاز، وتأهيل سوري مستقل قادرٍ على المساهمة في بناء ذاته، من ثم مجتمعه. واستمرار تمكينه بوصفها عملية لا تكتمل أبدًا، لكنها تتطور دائمًا.
ب) رسم سياسات توعوية على المستويات كلها.
ت) المساواة في الفرص، وحق الوصول إلى المعلومات، وحرية الفكر والتفكير، وتبني الآراء وتغييرها.
2) حرية الرأي والتعبير: أن يكون السوري حرًا في بناء رأيه الخاص والتعبير عنه، وأن يضمن أن أحدًا لن يمارس عليه العنف بسبب ذلك، سواء كان عنفًا ماديًا مثل عنف السلاح والتهديد الجسدي، أو العنف المعنوي الذي ينشأ من سلطات اجتماعية مثل سلطة القبيلة، والعشيرة، والعائلة، والطائفة، وكلُّ ما قد يتبع إليه الفرد من دون تفكيرٍ، فيصادر عليه حقه في تكوين مقارباته الخاصة.
3) حرية التنظيم: من حق الأفراد أن ينظموا أنفسهم في جماعات، وشبكات ثقة، مادامت أهدافهم ونياتهم تحت سقف القانون والأخلاق.
4) حرية الاعتراض: للسوريين كلهم حق الاعتراض، والتعبير السلمي عن هذا الاعتراض، ومن حقهم معارضة السلطة، وتنظيم فعاليات سلمية لهذه الغاية.
5) حرية الضمير: تتضمن حرية الفكر والوجدان والدين.
6) حرية الانتماء: لكل سوري الحق في الانتماء إلى فضاءٍ روحي وأخلاقي على المستوى الوجداني والثقافي، وله الحق في التعبير عن هذا الانتماء. حرية الانتماء إلى العروبة، والكردية، والأشورية، والسريانية، وغيرها، أمثلةٌ لهذا الحق وما يتضمنه من حرية استعمال هذه اللغات أيضًا، وحق التعلم بوساطتها. وللسوري حق التعبير عن ثقافاته في الفضاء الثقافي السوري.
رابعًا: حق السعادة:
من حق كل سوري أن يكون سعيدًا، وأن يسعى إلى السعادة. ويتضمن هذا الحق ما يلي:
1) مسؤولية الدولة عن بناء اقتصاد سوري متين وقوي يحقق رفاه السوريين، ويؤمن لهم الخدمات، وفرص العمل الملائمة لقدراتهم وتأهيل كلٍ منهم.
2) الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن.
3) الرعاية الصحية حقٌ وطني، وينبغي تطوير سياسات صحية ملائمة يتساوى فيه السوريين كلهم، في حق العلاج، والرعاية الصحية.
4) جبر الضرر: وقع على السوريين خلال السنوات السابقة ضرر مادي ومعنوي ينبغي تحقيق العدالة فيه كاملةً ومحاسبة المسؤولين عنه كلهم، والعمل على جبر هذه الضرر.
5) العدل: من حق السوريين أن تتحقق عدالة انتقالية في بلادهم؛ من ثم عدالة ناجزة وكاملة لها طابع الديمومة؛ فلا سعادة من دون عدل.
6) حق التمثيل:
أ) حقٌ لكل السوريين أن يتم تمثيلهم في السياسية الوطنية.
ب) حقٌ لكل السوريين أن يتم تمثيل السياسة الوطنية عندهم؛ فممثلي الشعب يعلمون في الاتجاهين معًا.
ت) حق السوريين أن يتم تمثيلهم في المجتمع الدولي، والمحافل الدولية، ومن حقهم أن يكون لديهم سياسة خارجية تنطلق من مصلحتهم القومية.
إذاً، باختصار: “نحن الشعب” تساوي “نحن مواطنون أحرار”، إضافةً إلى أربع كلماتٍ تأسيسية توافقية (الحياة، الكرامة، الحرية، السعادة)، نجعلها دستورية ونحتكم إليها، ونمضي إلى المستقبل.
————————————–
ما الذي تعنيه زيارة الشرع لأنقرة؟/ سمير صالحة
2025.02.08
أحمد الشرع في تركيا بحكم تقارب المصالح والتقاء الأهداف باتجاه إزاحة بشار الأسد أولًا، ثم القضاء على مجموعات “حزب العمال الكردستاني” المتواجدة تحت حماية ورعاية “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق الفرات وتطهير الحدود التركية-السورية منها ثانيًا، وإفشال مشروع الحكم الذاتي الانفصالي هناك ثالثًا، وبعدها التعاون والتنسيق على طريق بناء سوريا من جديد رابعًا.
كيف سيكون شكل التعاون بعد ذلك في السنوات المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون مرتبطة بنتائج تحقيق الأهداف الأربعة، وخارطة الطريق السياسية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية، وتوازنات الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بسوريا.
كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، أول الوافدين إلى دمشق للقاء الشرع، وهي الزيارة التي مهدت لقدوم وزير الخارجية، هاكان فيدان، كأول مسؤول رفيع المستوى يصل إلى العاصمة دمشق بعد سقوط النظام. عادي إذًا أن يصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة نظيره السوري، أحمد الشرع، إلى أنقرة بأنها تشكّل فصلًا جديدًا بدأ ليس فقط في العلاقات بين البلدين، بل على مستوى الإقليم ككل.
يتطلع الحوار التركي-السوري الجديد نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العلاقة بين البلدين، لكنه يعوّل أيضًا على اختراقات ثنائية بطابع إقليمي، بالتنسيق والتعاون الثنائي مع السعودية وقطر، كما لوحظ مؤخرًا.
تقرّ “هيئة تحرير الشام” وقياداتها، التي كانت محاصرة في إدلب، لتركيا، شئنا أم أبينا، بتسهيلها لها فرص الوصول إلى ما هي عليه اليوم. فأنقرة هي التي تجاهلت كل الضغوطات الإقليمية والدولية التي تعرضت لها منذ عام 2021، وتحديدًا في العامين الأخيرين، لحسم ملف الهيئة المصنفة على لوائح الإرهاب. لا، بل فعلت العكس تمامًا، إذ تغاضت عن نشاطات الهيئة باتجاه تعزيز نفوذها الإداري والسياسي في المدينة وجوارها، وتركتها تسيطر على مرافق إدارة شؤون المنطقة، وامتلاك الخبرة والتجربة التي استفادت منها لاحقًا عند تسلم إدارة شؤون سوريا.
التحول في مواقف وأساليب وخطوات قيادات الهيئة ونظرتها إلى كثير من المسائل والأمور كان مقدمة أساسية لا بد منها لتسريع عجلة الحوار والتقارب بين الجانبين. والترجمة العملية لذلك برزت من خلال التنسيق العسكري بين وحدات الهيئة و”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، عند إعلان ساعة الصفر وانطلاق العمليات في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي. التفاهمات تتم بعلم ومعرفة تركيا، وهي تُوّجت بالتقاط الصور التذكارية المشتركة في باحات القصر الرئاسي بدمشق.
دور تركيا لم يقتصر على ذلك، بل كان لا بد من تذكير “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تردد أنها شريك في صناعة الانتصار، لكنها لم تتردد في التحرك لاستغلال الفرصة الميدانية، بأن المسيرات التركية لن تسمح لها ببناء تفاهمات عسكرية سريعة مع النظام بقرار إيراني يهدف إلى عرقلة تقدم القوات باتجاه حلب والعمق السوري.
الشرع في أنقرة لبحث تفاصيل خطط وسيناريوهات المرحلة المقبلة في إعادة شرق الفرات إلى حضن سوريا الجديدة. هناك مواجهة يقترب موعدها ساعة بعد ساعة، وتفضل أنقرة ودمشق حلها سياسيًا عبر الحوار بدلًا من سيناريو الحسم العسكري، الذي لن ينتظر طويلًا. وهناك ملف “داعش”، الذي يجب تسليمه للسلطة السياسية السورية، حيث لا مشروعية لـ”قسد” في التمسك بهذه الورقة وتحويلها إلى فرصة أو وسيلة مقايضة مع دمشق. الحديث يدور عن بناء الدولة السورية من جديد، وعلى قيادات “قسد” أن تثبت حسن نواياها بإعلان تخليها عن ملف “داعش” لصالح السلطة المركزية، وإعادة السلاح الأميركي لأصحابه أو تسليمه لوزارة الدفاع السورية وقبول الواقع الجديد.
تردد قيادات “قسد” أنها منفتحة على الحوار وتريد أن تكون شريكًا في بناء سوريا الجديدة، على طريقتها وبما يرضيها. فصالح مسلم يقول إنهم مستعدون لكل السيناريوهات: “أنت عندما تصل إلى السلطة وتستطيع إسقاط النظام بمشاركة الشعب السوري، ثم تستولي على هذه السلطة وتحولها إلى سلطة تفرض الاستسلام على الآخرين، فهذا غير مقبول”. البديل السوري-التركي الذي على “قسد” أن تستعد له هو خطة تركية إقليمية تُبحث مع العديد من العواصم، لتسليم ملف “داعش” لدمشق بالتنسيق مع أنقرة.
والحديث الأميركي عن خطط سحب الجنود من سوريا يندرج، ربما، في إطار تفاهمات متعددة الجوانب تُناقش مع الجانب التركي حول هذا الملف.
احتمال كبير أن ترفض قيادات “قسد” وكوادر “حزب العمال الكردستاني” في شرق الفرات ما سيعلنه عبد الله أوجلان قريبًا باتجاه دعوة مناصريه للتخلي عن السلاح ونهاية حزب العمال، وأن يحاولا التمسك بالامتيازات والفرص التي حصلا عليها خلال عقد، بدعم بعض العواصم الغربية وتخطيط إيراني وسط تجاهل عواصم عربية. ومن أجل مواجهة سيناريو بهذا الاتجاه، تُعد أنقرة ودمشق لمزيد من التنسيق العسكري عند إعلان ساعة الصفر، حول من الذي سيقود ومن الذي سيدعم الآخر للقضاء على مشروع هذه المجموعات في شمال شرقي سوريا.
العقبة في العلن هي أميركية ومع الرئيس دونالد ترمب، وما الذي سيعلنه حول خطط الحرب على “داعش” والوجود العسكري الأميركي في سوريا. هو فرح لتراجع النفوذ الإيراني-الروسي في سوريا، وقد يثق بالحليف التركي ويسهّل له تنفيذ خطته الجديدة في شرق الفرات. لكن المشكلة الحقيقية قد تكون مع إسرائيل وتحريضها المتواصل في سوريا. تل أبيب تبحث عن دور على الجبهتين العسكرية والسياسية في العمق السوري، والهدف ليس قضم مناطق جديدة في الجنوب، بل الوصول إلى شرق الفرات بطلب وترحيب من “قسد”.
قمة ترمب-نتنياهو في واشنطن مهمة أيضًا بشقها السوري. هل سيأخذ ترمب بالنصائح الإسرائيلية ويترك الملف معلّقًا لإبقاء الفوضى والبلبلة الإقليمية بما يخدم مصالح نتنياهو، وهو ما سيتعارض مع مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ أم سيبحث عن التوفيق بين أنقرة وتل أبيب، آخذًا بعين الاعتبار حاجة واشنطن إليهما معًا في ملفات إقليمية تنتظر الحلول في القرم، وجنوب القوقاز، وشرق المتوسط، والممرات التجارية العابرة للقارات؟ وهل تكون المفاجأة الإقليمية الحقيقية في الطريق إلى ذلك طرح الرئيس الأميركي لمشروع صناعة سلام سوري-إسرائيلي؟
زيارة الشرع تحمل معها أبعادًا استراتيجية تتجاوز اللقاءات البروتوكولية، وهي مؤشر آخر على فرص القيادة السورية الجديدة في إعادة بناء البلاد من جديد، بعد الإعلان العربي والإقليمي والغربي عن الاستعداد للوقوف بجانب سوريا.
تلفزيون سوريا
———————————-
حول الخصخصة ونوايا الإدارة السورية الجديدة تجاه القطاع العام/د. عبد المنعم حلبي
2025.02.08
منذ هروب النظام، وفور تسلم حكومة الإنقاذ مهامها في دمشق كحكومة لتصريف الأعمال، دأب الفريق الاقتصادي فيها، ولاسيما عبر وزيري الاقتصاد والمالية على التأكيد بأن النهج الاقتصادي لسوريا المستقبل سيكون اقتصاد السوق الحر، وأن الخصخصة ستكون مصيراً حتمياً للقطاع العام، باعتباره قطاعاً خاسراً، ويشكل في جزء كبير منه عبأً على الخزينة العامة والدولة. فالنظام الساقط –من وجهة نظرهم- كان نظاماً اشتراكياً، وبالتالي فإن الخلاص النهائي منه يوجب الذهاب إلى الحرية الاقتصادية كنتيجة طبيعية لتحقيق الحرية السياسية. ولكن هل كان النظام السابق فعلاً نظاماً اشتراكياً؟ وهل يمكن تنفيذ التحول الحر هذا وما يشمل عليه من خصخصة للقطاع العام بصورة فورية وبأي طريقة كانت؟ أم أن الواقع والمصلحة الوطنية قد تشير إلى غير ذلك؟
في الواقع تشير التصريحات الحكومية بخصوص القطاع العام إلى تعميم واضح وتصور سلبي مسبق، بما يشمل مؤسسات الإنشاء والتعمير، شركات الصلب والتعدين، الكابلات، شركات تجميع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، وأيضاً الصناعات التحويلية النسيجية والغذائية وغيرها، وكذلك المؤسسات العامة التجارية بأنواعها المختلفة، وقد يمتد التعميم ليشمل الشركات التعاونية أيضاً. كما تتجاهل هذه التصريحات وجود قطاع مشترك لعبت فيه الدولة بمشاركة القطاع الخاص دوراً اقتصادياً مبنياً على عقلية الربحية والتنافسية، وإن بمتطلبات مجتمعية معينة.
في الجانب الأخر، يتم إغفال بحث الدور الذي لعبه القطاع الخاص أصلاً في الاقتصاد الوطني، في الفترة الماضية، ودوره في الأوضاع المزرية التي عانى منها شعبنا في ظل ما عاشته سورية منذ العام 1991، تجاه موارد الدولة والتزاماته الضريبية واحترامه لقوانين التأمين واهتمامه بإدخال التكنولوجيا الحديثة ومستويات الفساد فيه، ولا سيما بعد العام 2005، عندما تم التخلي عن اشتراكية الدولة وإطلاق منهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، ومنح القطاع الخاص الريادة في الاقتصاد الوطني بكل ما تعنيه الكلمة.
كما أن التحول الذي تؤكد عليه الحكومة، يتم -وفق الظاهر- دون تحديد استراتيجية واضحة المعالم، ودون الاستناد إلى إطار موسع من النقاشات والمداولات بين مختصين أكاديمياً وعملياً، سعياً لتحديد الأولويات المجتمعية ضمن خصوصية الحالة السورية، كما تثور أسئلة عديدة فيما إذا كان هناك خطة مبنية على أسس
قانونية وتشريعية، تبين مدى الاعتماد على السوريين فيها، وحدود الاستثمار الأجنبي المباشر المتاح، وآليات تستند إلى الشفافية في تنفيذ تلك الخصخصة، والتي يتوجب أن تكون ثمرة دراسات اقتصادية ومالية موضوعية لواقع مختلف المؤسسات الاقتصادية العامة وشركاتها، وليس مجرد تناغم مع أدبيات وتجارب غربية في مجال إعادة إعمار البلاد ما بعد الحروب، أو تنفيذاً لقرار ورغبة سياسية للقضاء على كل ما يرتبط بالنظام وبقاياه وآثاره، كامتداد للحالة الثورية. وعلى الرغم من تسجيل بعض التحركات التي يمكن وصفها بالإيجابية في بعض أنشطة الحكومة، وإن كانت على نطاق ضيق، تكمن هنا خطورة التذرع بالنوايا المعلنة لتبرير استمرار إهمال القطاع العام، وعدم بذل ما يجب بذله لاستئناف العمل والإنتاج، وبحث ما يمكن عمله لتأمين احتياجات السوق المحلية من العديد من المنتجات التي كانت لها حصة سوقية جيدة في بعض القطاعات النسيجية والغذائية وغيرها.
وإذا ما كانت تجارب الدول التي خرجت من نزاعات دامية، قد أكدت ضرورة وجودٍ رياديٍ للقطاع الخاص لاستعادة النهوض الاقتصادي، حيث تطغى شعارات الالتزام بتحرير الاقتصاد نتيجة التوجس من القطاع العام، بسبب هشاشة الدولة وضعف قدراتها والافتقار إلى المعلومات الدقيقة والمواكِبة، وكذلك الافتقار إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للإغاثة والإنعاش والتوسع في عملية إعادة الإعمار، وصعوبات في تشجيع ثقافة إعادة البناء الوطنية بين الموظفين العامين، وربما عامة المواطنين. إلا أن الواقع نفسه يقول إن الوكالات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف قد طبقت بالفعل نموذجاً يعطي الأهمية لأولويات السوق الحرة على حساب التنمية طويلة الأجل الشاملة والمملوكة وطنياً، والتي تقاد عبر مشاركة المجتمع المحلي من القاعدة إلى القمة، وبالتالي فإن الاعتماد على القطاع الخاص وحده، وعدم الاهتمام بزيادة قدرات مؤسسات الدولة ولعب دور اقتصادي سيؤدي إلى انخفاض قدرة الدولة على جذب التمويل في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي تقويض سلطة الدولة لصالح تكتلات أخرى تتلقى الدعم الخارجي المباشر. والتجارب نفسها تؤكد أنه وبقدر ما تتطلب نماذج إعادة الإعمار القديمة قدرة حكومية لكي تنجح، فإن تطبيق النماذج في الدول النامية الخارجة من النزاع سيفشل في تحقيق نمو أو تنمية مستدامة وشاملة أو سلام دائم، بدون حضور الدولة اقتصادياً واجتماعياً إلى جانب حضورها الأمني.
وانطلاقاً من واقع تجارب الدول السابقة أيضاً، والتي خاضت عملية إعادة الإعمار يتبين لنا، وهذا بديهي تقريباً، وجود حساسية عالية للقطاع الخاص فيما يتعلق بمعوقات التمويل، فعند نقصه لوحظ جنوح القطاع
الخاص نحو مد مرحلة التنفيذ، وربما التوقف وتعطيل التنفيذ في مشاريع قائمة بصورة طردية مع تباطؤ أو تدني التمويل. أو في حالة الفائض عن القدرات الاستيعابية للدولة وفق قاعدة العرض والطلب، حيث يجنح القطاع الخاص لزيادة أرباحه ورفع كلفته، وبالتالي ابتلاع جزء من هذا الفائض عبر المستويات نفسها من التنفيذ، وعدم توجهه للادخار وإعادة توجيه مدخراته نحو مشاريع إضافية، وذلك ولا سيما إذا توفرت الموارد الطبيعية من جديد، حيث يجنح القطاع الخاص بالاقتصاد نحو الريع، وما يرتبط بذلك من عمليات الفساد، والتي تتضافر مع عوامل أخرى في تكوين عقبات صعبة للغاية لأي إعمار فعال أو استقرار دائم.
ومن هنا فإن إعطاء الفرصة للقطاع العام سيؤدي إلى تحويل جزء من الفائض في التمويل -في حال توفره- نحو الشركات والمؤسسات التي يتم إثبات جدواها الاقتصادية ومشاركتها في العملية إعادة الإعمار والحفاظ على مستويات تنافسية مطلوبة مع القطاع الخاص، كما أن نجاح القطاع العام يعني منح قدرات تمويلية ذاتية، ستكون حلاً مؤقتاً في حالة انعدام التمويل وتباطئه.
وفي الختام يمكننا القول بأنه وعلى الرغم من التوجه المعلن -حالياً- باعتماد اقتصاد السوق الحر، بمعنى منح الفرصة للقطاع الخاص ليكون رائد الاقتصاد الوطني، فإن ذلك لا يجب أن يمنع من السعي الجاد، في إطار إعادة هيكلية القطاع العام، من الاعتماد على الفعاليات الاقتصادية الوطنية العامة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، من مؤسسات الإنشاء والتعمير، والشركات العامة التي كانت تتمتع بسمعة مقبولة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإن بصيغة تعاونية أو تشاركية مع القطاع الخاص الوطني، أو عبر شراكات مع الاستثمار الأجنبي وفق قواعد وصيغ التجارة الخارجية. وذلك بهدف توطين الجهات المنفذة بما يتوافق مع الموارد الوطنية المتاحة، والذي سيعطي فرصاً واسعة للموارد البشرية السورية الموجودة داخل البلاد، أو التي تستعد للعودة، لتأمين مصادر الكسب المعيشي، بما يتوافق وتحصيلها العلمي والمهني وبناء وتطوير قدراتها، ويسمح بدمجها مجتمعياً، في إطار عملية إعادة توصيف دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تبقى فيه الحكومة حيادية، وتستخدم قوة القانون في تأمين مواردها الضريبية، وحماية المستهلك، ومواجهة الاحتكار، والاستمرار -بصورة تنافسية مع القطاع الخاص- بتقديم الخدمات العامة، ولعب الدور المميز في التعليم والصحة ككل الدول التي تحترم شعوبها
تلفزيون سوريا
———————————–
على عكس التصور السائد، لا تريد تركيا أن تخرج أمريكا من شمال شرق سوريا بصورة كاملة؛ على الأقل ليس الآن/ رشاد عبد القادر
الانسحاب الأمريكي
على عكس التصور السائد، لا تريد تركيا أن تخرج أمريكا من شمال شرق سوريا بصورة كاملة؛ على الأقل ليس الآن.
الانسحاب الأمريكي:
– سيترك أولاً تركيا مكشوفة أمام عودة محتملة لتنظيم “داعش”.
– وثانياً، سيمهد الطريق أمام إيران لإعادة تشكيل نفوذها في شرق سوريا؛ فطهران لن تنسى أنها طُعِنت في الظهر، وبالتالي عودة حزب العمال الكردستاني المحتملة إلى بسط نفوذه على الحدود التركية.
– وثالثاً، سيفتح الباب واسعاً أمام إسرائيل لترمي بثقلها لتقطع الطريق أمام عودة أي نفوذ إيراني.
هذا فضلاً عن أن تركيا نفسها، لا تستطيع السيطرة على المنطقة الصحراوية في سوريا بأكملها، لدرء التهديدات الكثيرة التي سيخلّفها وراءه الانسحاب الأمريكي.
يعني هذا أن تركيا ليس لديها خيارات، وأنّ عليها أن تتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
إن كان الأمر ذلك، فلماذا تشن القوات الموالية لتركيا الهجمات على “قسد” قرب سد تشرين؟ تريد تركيا أن تَفْهم “قسد” أنها هي أيضاً ليس لديها خيارات. والهدف من هجمات “سد تشرين” ليس هزيمة “قسد”، بل الضغط عليها لتقديم تنازلات كافية.
ما الذي تريده تركيا؟
تريد تركيا:
– أن تطرد “قسد” المقاتلين غير السوريين،
– وأن تضم “البيشمركة” السورية الموالية للبارزاني، إلى وحدات حماية الشعب،
– وأن تلتزم بالاندماج الكامل مع دمشق.
والأهم، أن ترفع واشنطن العقوبات عن سوريا، لتفتح الباب أمام الشركات التركية لإعادة البناء.
ولكي ترفع واشنطن العقوبات، فهي تريد من تركيا أن تضغط على “هيئة تحرير الشام”، لكي:
– تطرد المقاتلين غير السوريين من صفوفها،
– وأن تضم الأطراف السورية الأخرى إلى العملية السياسية،
– وأن تكون المكونات المختلفة جزءاً أساسياً من العملية السياسية.
– وأن تقدم خطة قابلة للتصديق ومتكاملة للتعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية” والجهاديين. وهذه نقطة حاسمة، لن تتمكن “هيئة تحرير الشام” من تنفيذها من دون إشراك “قسد”.
لذلك، تسابق تركيا الزمن ليخرج الزعيم عبد الله أوجلان في أقرب وقت ممكن على شاشات التلفزيون، ويطلب من حزب العمال الكردستاني رمي السلاح. وهي تدرك أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، فقد لا يلتزم المتشددون في الحزب بما يطلبه أوجلان. لكن تعاوناً بين أنقرة – أربيل – واشنطن، سيحدّ من تأثير هؤلاء، وسيسهم في إخراج قوات سوريا الديمقراطية من تحت تأثيرهم، وتركيز جهودها على تمثيل مصالح كرد سوريا. ولن يكون مستغرباً، أن نجد عند نقطة ما، قوات مشتركة سورية وتركية و”قسد” لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
الآن، هل سيسير الأمر في هذا الاتجاه فعلاً؟ نعم، إن سار كل شيء على ما يرام. ولكن ليس بالضرورة، فالاحتمالات لا تزال مفتوحة في سوريا بوضعها الحالي. ولعل وجود معارضة حقيقية ليس أمراً صحياً فقط، بل ضرورياً لتوازن السلطة القائمة.
وربما أن السوريين الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم “سنّة” أولاً؛ ولا يتوانون عن إقصاء الآخر، ولا يخفون صيحاتٍ تصل أحياناً إلى درك “التطهير العرقي”، سيهدئون في نهاية الأمر. ويمكن تفسير سلوك هؤلاء (وليس تَفَهُّمُه) أنهم ناقمون على أنفسهم قبل الآخرين. ففي السنوات الأولى للثورة كانوا يؤمنون أن الله سيقف إلى جانبهم. وعندما لم يستجب (بحسب تصوّرهم)، ظنّوا أنه ابتلاهم إلى حين. وعندما امتد البلاء، اهتزّت علاقة بعضهم مع الرب؛ وبعضهم ترك الدين بأكمله، فيما اعتنق آخرون ما يعتبرونه “قيماً غربية”؛ ثم جاء “الرد الإلهي من حيث لا يحتسبون”، والآن يريدون تعويض “الشكوك” التي انتابتهم، بـ”التطرف” عقاباً للذات وجلداً لها، وللآخرين أيضا.
الفيس بوك
————————–
الشّرع ينفّذ وثبة ثلاثيّة إقليميّة… بنجاح/ سمير صالحة
2025-02-08
من كان قبل أسابيع يراهن على سقوط سريع ومدوٍّ لنظام بشار الأسد المتشبّث بكرسي الرئاسة بدعم إيراني – روسي؟ من كان يقول إنّ الميليشيات وجيش المستشارين الوافدين من كلّ صوب لحماية نظام الحكم في سوريا منذ عقد، سينفرط عقدهما وتكرّ سبحتهما خلال 10 أيام أمام “هيئة تحرير الشام” التي ما زالت على لوائح الإرهاب، فيدخل الشعب قصره معلناً ولادة مرحلة سياسية جديدة في البلاد؟
من كان يتوقّع أن يفرش السجّاد الأحمر في مطارات دمشق والرياض وأنقرة لأحمد الشرع بصفته الرئيس السوري الجديد، فاستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو أوّل ضيف عربي يزور دمشق لساعات، قبل أن يستقلّ الشرع طائرة سعودية تنقله إلى الرياض على رأس وفد رفيع للقاء وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ثمّ يغادر بطائرة تركية تنقله إلى العاصمة أنقرة حيث كان الرئيس رجب طيّب إردوغان بانتظاره؟
الشّرع حدّد أولويّات المرحلة الانتقاليّة
حدّد الشّرع أولويّات المرحلة الانتقالية بالنسبة للسلطة السياسية المؤقّتة التي يقودها في سوريا، وتحدّث فيها عن الجوانب السياسي والدستوري والاجتماعي والإصلاحي التي ينتظرها الشعب السوري يوماً بعد يوم، والتي يتقدّمها توحيد الأراضي السورية تحت سلطة الدولة، وتشكيل حكومة يتمثّل فيها الجميع، وإنشاء هيئة تشريعية مصغّرة ولجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. هذه الرسائل أرضت الداخل والخارج وأعلنها بعد ساعات على تنصيبه رئيساً للجمهورية وقبل ساعات من استقباله أمير قطر وتوجّهه إلى الرياض وأنقرة.
يستعدّ اليوم للانفتاح على أوروبا، وحديثٌ عن احتمال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض خلال زيارته المرتقبة للمملكة بمبادرة سعودية استراتيجيّة البعد. ماذا يريد أكثر من ذلك وهو لم يغادر بعد لوائح الإرهاب التي تتمسّك بها العواصم والمنظّمات الدولية؟
يقول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنّ محاولات البحث عن حلول مستوردة لمشاكل محلّية لم تجلب السلام لمنطقتنا. بل على العكس تماماً، ما فعله الخارج دائماً (كان) حمل لنا عدم الاستقرار والحروب من أجل حماية مصالحه عندنا. من المبكر طبعاً الحديث عن تحالف عربي – تركي رباعي أو محور إقليمي يتشكّل يوماً بعد يوم حول سوريا. لكنّ التقاء المصالح على ضرورة إعادة بناء سوريا وحاجة الدول الثلاث إلى أن ترى دمشق لاعباً عربياً إقليمياً يستردّ دوره وثقله، وهو ما يقرّب بينها اليوم ويدفعها لفتح الأبواب على وسعها أمام القيادة السورية الجديدة.
الشّرع يحقّق الوثبة الثّلاثيّة
الوثب الثلاثي أو القفز الثلاثي هو أحدث ألعاب القوى التي أُدخلت في الدورات الأولمبية، ويتمّ فيه أداء ثلاث قفزات متتالية. في نهاية القفزة الأولى يجب على المتسابق أن يلامس الأرض بالقدم نفسها التي بدأ بها السباق. وفي القفزة الثانية يجب أن يلامس الأرض بالقدم الأخرى، وفي نهاية القفزة الثالثة تكون ملامسته للأرض بالقدمين معاً. تشتهر هذه الرياضة بأنّها تتطلّب مهارات عالية في التنسيق والسرعة والقوّة والمرونة. وتتميّز بأنّها تحتاج إلى تنسيق جيّد بين الجري، الوثب، وتبديل القدمين بشكل دقيق.
الشّرع
سياسياً ودبلوماسيّاً هذا ما حقّقه أحمد الشرع خلال شهرين فقط، محطّماً رقماً قياسياً في الوصول إلى السلطة وقلب الموازين في سوريا والتواصل مع العديد من العواصم العربية والإقليمية على خطّ الذهاب والإياب، معلناً برشاقة وعبور سلس ولادة دولة سوريّة جديدة.
التحدّيات التي تعترض طريق الشّرع كثيرة، في الداخل والخارج، بينها إعادة بناء وتشغيل عجلة الاقتصاد وتوفير الأمن وتوحيد سوريا، الأمر الذي سيفرض على الشرع تعزيز حضوره الإقليمي والدولي. وهنا يدخل الثلاثي العربي – التركي على الخطّ لتفعيل الفرص وتسهيل التواصل.
منذ اللحظات الأولى لإعلان سقوط نظام الأسد وبدء مسيرة بناء سوريا الجديدة، كان واضحاً أنّ هناك توافقات تركية – سعودية – قطرية باتّجاه دعم هذه الفرصة التاريخية لسوريا والسوريين من أجل بناء دولتهم الجديدة.
أوّل ارتدادات الانفتاح التركي – السعودي – القطري على دمشق بعد الزيارات السياسية والاقتصادية والأمنيّة المكثّفة داخل هذا المربّع الجغرافي الإقليمي، جاء من أوروبا، حين دعا الاتّحاد الأوروبي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى زيارة بروكسل قريباً. وأعلنت الرئاسة السورية أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتّصل بالشرع مهنّئاً على تولّيه منصب الرئاسة، موجّهاً له دعوة لزيارة باريس في الأسابيع المقبلة، مبدياً دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا.
قد لا يكون التوافق الثلاثي التركي – السعودي – القطري ساهم في إزاحة نظام الأسد عن الحكم قبل شهرين، لكنّ تطوّرات ما بعد الثامن من كانون الأوّل المنصرم تقول إنّ هذا الدعم الثلاثي المقدّم للشرع هو الذي سيفتح الطريق أمامه لمواصلة مسار المرحلة الانتقالية في سوريا ويسهّل وصوله إلى العواصم الإقليمية والدولية، والحصول على الدعم الدولي لوقف العربدة الإسرائيلية في سوريا ورسائل تل أبيب التحريضية والمطالبة بضرورة تنفيذ اتّفاق “فضّ الاشتباك” الموقّع عام 1974.
أساس ميديا
—————————————
طهران تريد لبنان منصّة ضدّ سوريا الجديدة؟/ وليد شُقَير
2025-02-08
يصعب فصل التعثّر في استيلاد حكومة الرئيس نوّاف سلام عن التعقيدات الإقليمية. فالبلد ساحة صراع بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية. وهو ما يلقي بظلاله على إعادة تكوين السلطة فيه، التي لطالما شكّل نفوذ طهران داخلها إحدى أوراقها الإقليمية.
غرقت بعض القوى المحلّية في حملة على رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام وعلى المرشّح لشغل منصب نائب رئيس الحكومة طارق متري، فضاعت بوصلة اتّجاه الأحداث.
على الرغم من الخسائر التي مُنيت بها طهران نتيجة حرب إسرائيل على غزة، ثمّ على لبنان، وصولاً إلى الزلزال السوري… ما تزال تعاند. وما يعتبره خصوم طهران و”الحزب”، مكابرةً وإنكاراً للهزيمة، هو في نظرها تمسّك بمكتسبات كلّفتها عقوداً من التخطيط والأثمان.
“إزعاج” الغرب بـ”التّعطيل”… ومغامرة “الإسناد”
على الرغم من اعتداد إيران بأنّ بيروت إحدى العواصم العربية الأربع التي سيطرت عليها، كانت ضمناً تخطّط لمزاحمة النفوذ الغربي والأميركي فيه. هدفها على الدوام أن تكون مصدر إزعاج لحليف الغرب الأوّل، إسرائيل، حتّى تحمِل الدول الكبرى على مفاوضتها. غرقت استراتيجية الإزعاج هذه في مغامرة سوء الحسابات بحرب “إسناد غزة” التي انتهت إلى خسائر كبرى.
كانت الترجمة اللبنانية لإزعاج نفوذ واشنطن اكتساب القدرة على تعطيل قرار الحكومات بعد السيطرة على تشكيلها والموازين داخلها. كان نفوذها على الرئاسة الأولى يتيح أن تمسك بزمام الأمور. وحين كانت تتمّ مواجهة التعطيل من الخصوم، كان يُستخدم فائض القوّة والسلاح.
إشارات التّفاوض المتأخّرة مع أميركا
جاءت متأخّرةً إشارات التفاوض مع أميركا، التي أطلقتها القيادة الإيرانية بعد انتخاب الرئيس مسعود بزشكيان. على الأقلّ هذا ما أبلغه وزير عربي لعب أدواراً في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، للجانب الإيراني قبل أشهر، حسب معلومات “أساس”. وهذا ما يفسّر التخبّط في المواقف الإيرانية. ولم ينفع استباقها لحملة “الضغوط القصوى” التي بدأها دونالد ترامب أوّل من أمس بالعقوبات على تصدير النفط الإيراني إلى الصين.
واجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اغتيال السيّد حسن نصرالله بدعوة اللبنانيين إلى “المقاومة”، متوقّعاً انتصارها. وحين نظّم “الحزب” دخول محازبيه وأنصاره القرى الحدودية التي لم تنسحب منها إسرائيل، وسقط 26 قتيلاً لبنانياً، اعتبر خامنئي ذلك انتصاراً عظيماً لـ”المقاومة”. سقوط بشار الأسد بعد انسحاب الميليشيات الإيرانية و”الحزب” من بلاد الشام رأى فيه مخطَّطاً أميركياً إسرائيلياً متوقِّعاً نهوض “المقاومة”، وواكبته تصريحات بهذا المعنى من الخارجية و”حرس الثورة”. آخرها في 4 شباط الجاري من قائد الحرس حسين سلامي حين قال: “الوضع في سوريا لن يبقى على حاله، و”الحزب” ظلّ صامداً على الرغم من الضربات الثقيلة التي تلقّاها”.
أهداف الامتناع عن تسليم السّلاح
ثمّة إشارات إلى أنّ طهران “تقاوم” محاولات واشنطن تكريس ميزان إقليمي للقوى بناءً على نتائج حرب إسرائيل ضدّ “الحزب”، وعلى الضربات الجوّية التي تلقّتها على أراضيها من قبل إسرائيل، وعلى الزلزال الذي أخرجها من سوريا:
– امتناع “الحزب” الضمنيّ عن تفكيك بنيته العسكرية جنوب الليطاني وفق اتّفاق وقف النار، على الرغم من موافقته عليه عبر الرئيس نبيه بري في 27 تشرين الثاني الماضي. إسرائيل اعتمدت ذلك حجّة لتمديد بقائها في قرى الحافة الأمامية لممارسة أعمالها العدائية بمضاعفة التدمير الذي أحدثته قبل الاتّفاق. وفصله وجود السلاح جنوب الليطاني عن شماله أدخل الوضع العسكري جنوباً بدوّامة مفرغة: إسرائيل تتذرّع بتمنّع “الحزب”، والأخير يتذرّع ببقاء إسرائيل للاحتفاظ بترسانته. هكذا يتمدّد قصف العدوّ من الجنوب إلى البقاع، كما حصل أوّل من أمس.
يسمح ذلك لأوساط سياسية بقراءة هذه الإشكالية على أنّ طهران تحتفظ بالصواريخ الدقيقة البعيدة المدى (لم تُستخدم خلال حرب الإسناد) لاحتمال مواجهة مع إسرائيل إذا أطلق ترامب يدها العسكرية ضدّ إيران. هذا إذا لم تستجب لأفكاره التفاوضية حول ملفّها النووي وبرنامجها الصاروخي والجوّي، وتخلّيها عن أذرعها الإقليمية. أخذت الضغوط القصوى على طهران أبعاداً واسعة في الأسبوعين الماضيين. وليس صدفة أن تتزامن الضربات ضدّ امتداداتها في ألمانيا والسويد ودول أوروبية أخرى. تضاف إليها تسريبات عن محاولاتها تهريب الأموال عبر جهات ثالثة إلى “الحزب” في لبنان.
طلب طهران رعاية نازحين إيرانيّين
– كانت لافتة زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية وحيد جلال زادة بيروت في 31 كانون الثاني الماضي. فهو طلب من الحكومة اللبنانية أن “تحتضن وترعى الأخوة السوريين الذين نزحوا نتيجة المستجدّات إلى لبنان من سوريا، وعدد منهم من أصول إيرانية”. والتقى بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب والمدير العامّ للأمن العامّ اللواء الياس البيسري لهذا الغرض. والتقى أيضاً عدداً من الإيرانيين المقيمين في لبنان وسوريا، وأشار إلى أنّ “حوالي 130 ألف سوري نزحوا”.
تساءل مراقبون عن أبعاد أمنيّة لبقاء هؤلاء على الأراضي اللبنانية (في منطقة بعلبك – الهرمل القريبة من الحدود مع سوريا). فالمئات منهم ينتمون إلى الميليشيات الموالية لحرس الثورة التي استقدمتها طهران لحماية النظام المخلوع وترسيخ نفوذها. وبعضهم انسحبوا من سوريا مع أسلحتهم. فهل يكون لهم دور في سعي طهران إلى تغيير “الحال” في سوريا؟
تهريب من مستودعات أسلحة في سوريا؟
– تقول مصادر سوريّة لـ”أساس” إنّ “الحزب” يسعى منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية في 8 كانون الثاني، إلى استعادة أسلحة ثقيلة وخفيفة من مستودعات سرّية احتفظ بها في سوريا، لنقلها إلى لبنان عبر طرق التهريب غير الشرعية التي تحاول السلطات الجديدة إقفالها. وغالباً ما تشتبك مع مهرّبي السلاح وغيره. آخر هذه الاشتباكات الصدام العنيف بينها وبين مسلّحين مدعومين من “الحزب” في قرية “حاويك” السورية التي يقطنها لبنانيون، منذ الخميس الماضي. وتربط المصادر نفسها بين هذه المحاولات وبين تعاون محتمل بين فلول إيران وما تسمّيه فلول الميليشيات المؤيّدة للنظام المخلوع في الساحل السوري وبعض ريف حلب الشمالي وحمص.
الخلاف على الشّيعيّ الخامس
ما علاقة ذلك بتشكيل الحكومة اللبنانية والخلاف على تسمية الوزير الشيعي الخامس؟
يستدلّ البعض من الإشارات المذكورة على أنّ طهران لن تسلّم بمستجدّات الأشهر الماضية الجيوسياسية وتسعى إلى “مقاومتها”. وهذا يشمل عدم تخلّيها عن نفوذها في قلب السلطة اللبنانية والاحتفاظ بقدرتها التعطيلية داخلها على الرغم من تسليمها برئاسة العماد جوزف عون مضطرّة. وحاجتها إلى الارتداد على هذه المستجدّات تملي على “الحزب” أن يبقي على دوره السابق، فيما يسعى خصومه إلى إفقاده امتياز التعطيل الذي تمكّن من الاحتفاظ به بعد ثورة 17 تشرين 2019 ضدّ المعادلة السياسية والتدهور الاقتصادي.
نجح “الحزب” في ذلك، فحال، بتحالفه مع الرئيس ميشال عون، دون تشكيل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حكومته التي كانت معاييرها تشبه معايير الرئيس نوّاف سلام، فاضطرّ إلى الاعتذار. وتسبّب إصرار “الحزب” وحلفائه على الاحتفاظ بقدرة التعطيل باعتذار السفير مصطفى أديب بعدها. لكنّ حكومة حسان دياب وحكومة نجيب ميقاتي التي تتولّى تصريف الأعمال حالياً أخذتا كلٌّ على طريقتها بمتطلّبات المرحلة عند تشكيلهما.
استطاع سلام الحؤول دون حصول “الحزب” على الثلث المعطّل في تشكيلته الحكومية، وحين سعى إلى الحيلولة دون حصول الثنائي الشيعي على القدرة التعطيلية باسم الميثاقية، تعثّرت ولادتها. برفضه التسليم بتسمية الثنائي للوزراء الشيعة الخمسة يحول دون أيّ إمكانية لأن تتسبّب استقالتهم جميعاً بتعطيلها بحجّة أنّ مكوّناً طائفياً انسحب منها. فسلام يمثّل فريقاً واسعاً من اللبنانيين يريد تحييد البلد عن مجريات المواجهة أو التفاوض بين طهران وواشنطن. هذا علاوة على تحوّطه لتعطيل الإصلاحات المطلوبة.
ما يعاكس القراءة المذكورة هو السؤال عن إصرار الرئيس برّي على تسمية الوزير الشيعي الخامس، وهو الذي تمايز عن “الحزب” وعارض زجّ الجنوب بحرب الإسناد الإيرانية؟
الخشية من استضعاف الطّائفة
ثمّة من يعتقد أنّ برّي المتخوّف دائماً من أن ينسحب استضعاف “الحزب” على دور الطائفة المرجِّح، الذي اكتسبته بفعل قوّة السلاح. وهو الدور الذي كان ينتج بحنكته نفوذاً استثنائياً بالدولة، وربّما كان سعيه إلى احتكار التمثيل الشيعي صمام أمان لذلك النفوذ المتراكم. ولذلك لم يكتفِ، على الرغم من تمايزه عن “الحزب”، بتطمين نوّاف سلام له الذي كلّفه من رصيده الشخصي، كما قال، بإسناد حقيبة المال إلى الطائفة.
المؤكّد في هذا المجال، حسب معطيات دبلوماسية غربية، أنّ برّي لم يحصل على وعد بأن يكون له أو لـ”الحزب” أيّ ثمن في المعادلة الداخلية، مقابل دوره في ترجيح اتّفاق وقف النار في الجنوب.
أساس ميديا
——————————–
قصة المعركة التي أسقطت الأسد في اثني عشر يوماً/ عبد الله الموسى
2025-02-07
فجر اليوم الأخير من المعركة، صعد شبان دبابة متروكة وسط ساحة الأمويين، وركنت أربع صبايا سيارتهنّ قربها على صوت عبد الباسط الساروت يغنّي “جنّة جنّة جنّة.. جنّة يا وطنّا”، مُعلنين سقوط الأسد ونظامه قبل دخول أي مقاتلين من الفصائل إلى العاصمة، في مشهدٍ توّج أعواماً من التخطيط لمعركةٍ امتدت اثني عشر يوماً مشحونة بالتفاصيل.
دخل قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مطلع شهر فبراير 2020 غرفةَ عمليات “الفتح المبين”، التي جمعت قيادات الفصائل الجهادية والمعارضة السورية، صارخاً على قادة جيوشه مطالباً إياهم بزيادة المقاتلين وبدء معركة لاسترجاع مدينة سراقب التي وصلت إليها قوات النظام بعد تسعة أشهر من المعارك العنيفة. كانت قوات النظام وإيران قد تقدمت تحت غطاءٍ جوّي روسي من ريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي وسيطرت على ألفين وثلاثمئة كيلومتر مربع في طريقها إلى سراقب، ثم خمدت المعارك باتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. لم يكن بمقدور القادة العسكريين في هيئة تحرير الشام فعل المزيد، فقد خسروا في الأشهر التسعة أكثر من ألف وخمسمئة مقاتل من قوات النخبة، واضطروا لتنفيذ سبعٍ وعشرين عملية انتحارية لوقف تقدم قوات النظام وإيران دون جدوى، عدا عن خسائر كبيرة للفصائل الأخرى التي شاركت في المعارك.
من غرفة العمليات ذاتها، وبعد أربع سنوات وتسعة أشهر وتغيّرات كبرى وأحداث لم يكن يهتم لها سوى ستة ملايين سوري محشورين في زاوية البلاد الشمالية الغربية، انطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 نوفمبر 2024 في مفاجأةٍ لم يتوقعها أحد. وفي مواجهة الفصائل المشاركة كانت خطوط النظام في ريف حلب الغربي تتهاوى أسرع من المعتاد، وكانت القلوب ترتجف لاحتمال انتهاء المعركة كسابقتها إلى انتصارٍ منقوص يتسبب بحملاتِ قصفٍ انتقامية على منطقة محاصرة مكتظة نعمت بالهدوء لأكثر من أربع سنوات من وقف إطلاق النار. لكن الأهالي كانوا مُهيَئين نفسياً بعد أن راجت شائعات بدء المعركة ست مرات في فترةٍ لم تزد عن خمسين يوماً، وفي آخر مرتين كانت المؤشرات أوضح. سجلت شبكة منسقو استجابة سوريا، وهي شبكة أهلية معنية بالإغاثة، نزوحَ عشرات الآلاف من أرياف حلب وإدلب في بيان نشرته يوم 27 نوفمبر 2024، وقالت إن السبب كان تصاعد القصف الروسي في السابعة من صباح ذلك اليوم. لكن البداية كانت في فتح هيئة تحرير الشام نيرانها معلنة بدء معركة لم يتوقع أكثر المتفائلين أنها ستتخطى مدينة حلب، في حين كان المخططون قد رتبوا كل شيء لإدارة منطقة تشمل مدينة حماة الواقعة وقتئذ تحت سيطرة النظام السوري.
بعد اثني عشر يوماً من تلك اللحظة، انهارت قوات نظام بشار الأسد وانتهى حكمه، مما فتح الباب أمام نظريات مؤامرة حاولت تفسير الحدث الهائل المعارض للمنطق. لكن الحقائق، وإن غابت عنها التفاصيل، كانت بادية للمتابع المدقق. فالتجهيز العسكري والتقنيات الجديدة والتخطيط الدقيق وتوقيت المعركة المرتبط بتغيرات إقليمية رسمت صورة الإعداد لمعركةٍ أسقطت الأسد، فحققت ما فقد الكثيرون الأمل في تحققه.
مع انتهاء المعركة في مدينة سراقب في مارس 2020 باتفاق أردوغان وبوتين الذي عُرف باتفاق سوتشي، أدرك أبو محمد الجولاني الذي عاد لاحقاً لاسمه الرسمي أحمد الشرع أن هيئة تحرير الشام غير قادرة على الدفاع عن منطقة سيطرتها، وبدا الضعف العسكري فيها كبيراً وهو ما دفعه لإعادة حساباته. فكانت المراجعات الفكرية في البداية بتبنّي الخطاب الثوري والمعتدل بعيداً عن الخطاب الجهادي المعتاد، وتعزيز الحوكمة عبر ذراعه المدني المتمثل بحكومة الإنقاذ، وتعزيز جهاز الأمن العام وتقوية العلاقة بفصائل في الجيش الوطني السوري وهو فصيل من الجيش الحر أعادت تركيا تنظيمه وتدريبه.
تقول مصادر عسكرية من هيئة تحرير الشام للفِراتْس إنه منذ ذلك الحين كان آلاف المقاتلين يتدربون سراً، وكان المجلس العسكري الذي يجمع الفصائل يخطط لاقتناص الفرصة الأمثل وقلب الطاولة. وفي ذروة اللقاءات بين نظام الأسد وتركيا في موسكو وظهور مؤشرات لعملية تطبيع بينهما، قال الجولاني في 27 مايو 2023 وسط مؤتمر لأهالي مدينة حلب وناشطيها ووجهائها استضافه الجولاني في ريف إدلب إن “الجاهزية العسكرية وصلت إلى أعلى مداها، وإني أراكم تجلسون في حلب كما تجلسون أمامي الآن”.
منذ تأسيسها سنة 2012، شهدت جبهة النصرة (التي سُمّيت بعدها جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام) تغييرات هيكلية بارزة في تشكيلاتها العسكرية، بدءاً من القواطع (الكتائب)، ثم الجيوش المناطقية التي ظهرت بعد موجات التهجير إلى الشمال السوري. حملت هذه الجيوش أسماء المناطق المُهجَّرة مثل جيش حلب وجيش حماة، قبل أن تُستبدل لاحقاً بأسماء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
في رمضان سنة 2020 تشكّل المجلس العسكري لمحافظة إدلب بعد اتفاق قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني مع قائد حركة أحرار الشام الإسلامية جابر علي باشا وقائد فيلق الشام منذر سراس (والأخيران ضمن الجبهة الوطنية للتحرير). وتشكّل المجلسُ من ثلاثة مندوبين، هُم مرهف أبو قصرة (أبو الحسن 600) والنقيب عناد درويش (أبو المنذر) ومحمد الغريب (أبو أسيد، محمد حوران). وسنة 2021 باتت حركة أحرار الشام بقيادة عامر الشيخ، بعد خلافاتٍ داخل الحركة نُفيت فيها القيادة القديمة إلى ريف حلب الشمالي وانضمّت للجيش الوطني. كان هذا المجلس العسكري نقطة التقاء الفصائل المتبقية في إدلب لإدارة الوجود العسكري، والتي شكّلت غرفةَ عمليات “الفتح المبين” لتصبح بمثابة قيادة الأركان. ومع تشكيل المجلس العسكري غيّرت هيئة تحرير الشام هيكلتها وقُسمت الجيوش الأربعة إلى اثني عشر لواءً حملت أسماء شخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي مثل خالد بن الوليد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام إلى جانب ألوية أخرى مثل العصائب الحمراء، وهدفت هذه الخطوة إلى إزاحة أي تهديد داخلي قد يقوم على التكتل المناطقي.
نشرت الهيئة عدة مقاطع مصورة أظهرت تدريب الفصائل العسكرية مقاتليها في معسكرات تدريب صعبة رفعت من استعداداتهم القتالية والبدنية مستفيدةً من وجود مدربين أجانب من ألبانيا والشيشان وداغستان كانوا ضباطاً في القوات الخاصة في بلدانهم قبل أن يقودوا تشكيلات عسكرية ويدربوها في سوريا. كنت أراقب هذه المعسكرات عن قرب وألحظ الفرق بينها وبين المعسكرات الاستعراضية التقليدية، ولفتني أنها لم تكن لغاياتٍ دفاعية بل هجومية.
جهّزتْ هيئة تحرير الشام فرقاً للمدفعية والصواريخ وقوات نخبة قوية، أبرزها فرقة العصائب الحمراء. وفي الفترة من 2022 إلى ما قبل معركة إسقاط نظام الأسد في 2024 شكّلت الهيئةُ سرايا الحراري، وهي مجموعات من عشرة مقاتلين نخبة بأسلحة رشاشة وقواذف مجهزة بمناظير حرارية ليلية وكواتم صوت. تتحرك هذه السرايا مدعومة بالطائرات المسيرة المزودة بآلات تصوير ليلية تكشف لهم المنطقة المحيطة وتبث لقطاتها لغرفة العمليات لتوجيههم. شنّت الهيئة بهذه السرايا إحدى وأربعين عملية على خطوط الجبهة من اللاذقية إلى ريف حلب الغربي أسمتها “عمليات انغماسية”، كانت أكبرها في أغسطس 2023 في جبال اللاذقية في قمة النبي يونس، بعمق ثمانية كيلومترات عن خط الجبهة مستهدفةً غرفة عمليات للنظام وروسيا.
أكدت مصادر عسكرية من القيادة العسكرية المشتركة للفِراتْس أن هيئة تحرير الشام أطلقت برنامجاً لتصنيع الطائرات المسيرة واستعمالها سنة 2017. وكان هيكل الطائرات البسيط في البداية هدفاً سهلاً للإسقاط، لكبر حجمه وبطئه وضعف منظومة التحكم والاتصال. ثم تطور وبلغ مرحلة جيدة نهاية سنة 2021. لكن تصنيع المُسيرات قفز قفزة كبيرة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 إثر تحليل بنية ووظيفة وطريقة عمل المُسيرات الصغيرة من طراز “إف بي في” التي وصلت إلى سوريا حينها، وبعد تدخلات وتعديلات أنتجت مسيرات شاهين.
جمعت الفِراتْس من مصادر أمنية وعسكرية خاصة داخل الهيئة قصة تطوير مسيرات شاهين، التي بدأت منتصف سنة 2022 حين ودّع مقاتل يُعرف باسم عبدالكريم الأوكراني إدلب بعد أن قضى فيها إحدى عشرة سنة مشاركاً في معظم معارك الشمال السوري. ومثل كثير من المقاتلين الشيشانيين والأوكرانيين، عاد عبدالكريم من سوريا إلى أوكرانيا للقتال ضد الروس عبر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً باسم “قسد” وبالتعاون مع المخابرات الأمريكية. فكان عبدالكريم نقطة وصل بين هيئة تحرير الشام والاستخبارات الأوكرانية. وبلغ التنسيق حدّ إرسال المسيرات مخبأة في شحناتٍ تجارية، ويَسَّر تبادل الخبرات عن بُعد بين التقنيين المسؤولين عن برنامج المسيرات في هيئة تحرير الشام والقوات الأوكرانية – وهو ما علمت به موسكو وأعلنت عنه محذرة في سبتمبر 2024، أي قبيل بدء معركة ردع العدوان بشهرين اثنين – فشكلت الهيئة سرايا من الشبان الموهوبين في ألعاب الفيديو، الذين تدربوا جيداً على تطويع المسيرات بعمليات المحاكاة وفي الميدان.
حصلت الفصائل العسكرية على صواريخ غراد يبلغ مداها ستون كيلومتراً، وصواريخ بمدى أقل طوَّرتها لإصابة الأهداف بدقة. ويحمل أكبر الصواريخ شحنةً متفجرةً بوزن ثلاثمئة كيلوغرام بِمدى يصل خمسة كيلومترات وبِهامش خطأ يبلغ عشرة أمتار. ثم بلغ التطوير مرحلة دمج برنامجي المسيرات والصواريخ لتكون ثمرته صاروخاً مجنحاً باسم “زؤام” كشف عنه إعلام الهيئة في نوفمبر 2024 قبل أيام من بدء المعركة، وهو صاروخ يُتحكّم به كالمسيرات بعد انطلاقه ليُقاد إلى هدفه.
في السنوات الثلاث التي سبقت معركة ردع العدوان، بدأت هيئة تحرير الشام بناء علاقات مع فصائل في الجيش الوطني السوري، فتغيرت التحالفات وأصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم وأصدقاء الأمس أعداء اليوم. ثم انقلبت الآية مجدداً وعادت التحالفات إلى نصابها القديم، تخللها اشتباكات ومحاولة الهيئة السيطرةَ على مناطق شاسعة في ريف حلب الشمالي، وكان وراء التحالفات وانتكاساتها صراع تيارين في المخابرات التركية المسؤولة عن الملف السوري.
وفي ذروة ذلك وقعت “أزمة العملاء” نهاية سنة 2023، عندما اكتشف جهاز الأمن العام التابع للهيئة خلايا عملاء تتبع روسيا والمخابرات الأمريكية. فطالت الاعتقالات المئات، بينهم قادة عسكريون تعرضوا للتعذيب. انفجر الوضع داخل صفوف الهيئة وشكّل الجولاني لجنة للبتّ في قضايا المشتبه بهم والمتهمين، أُطلق سراح معظمهم، ثم بدأ جولة تسامح مكثفة. انتهت أكبر أزمة ضربت صفوف التنظيم منذ إعلان انفكاك جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة في يوليو 2016.
وحين انتهت أزمة العملاء بدأت الدعوات التركية رئيسَ النظام السوري بشار الأسد لتطبيع العلاقات، فاندلعت مظاهرات عنيفة في الشمال السوري في يوليو 2024، وهاجم مدنيون ومقاتلون القواعدَ العسكريةَ التركيةَ ووصلت رسالة حادة اللهجة لأنقرة. لكن دعوات التطبيع مع الأسد عادت جدياً دون ردّ من الأسد، لم تهمّ هذه التحولات الداخلية الكبيرة غير سكان الشمال السوري. بالتزامن، كان الوضع قد انفجر إقليمياً منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة. فأثرت حرب لبنان والضربات القاضية التي تلقاها حزب الله، والغارات الإسرائيلية ضد قادة الحرس الثوري الإيراني ومقراته في سوريا، وشبه اليقين الإيراني بتورط النظام السوري بها في الخارطة السورية. نأى الأسد بنفسه عن الحرب الإقليمية لكن ذلك لم ينفعه. أما الروس فقد سحبوا معظم قواتهم في سوريا إلى أوكرانيا منذ أكتوبر 2022، وشمل ذلك الجنود والضباط الخبراء والمعدات العسكرية والقتالية. وبقي لموسكو قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس، موطئ القدم الروسي الوحيد على المتوسط. وقد رصد موقع تلفزيون سوريا في منتصف ديسمبر 2024 إبقاء موسكو إحدى عشرة طائرة سوخوي فقط في قاعدة حميميم، بينما كان عدد الطائرات الروسية لا يقلّ عن سبعين طائرة في ذروة الوجود العسكري الروسي في سوريا.
قال الجولاني إن التجهيز العسكري لمعركة ردع العدوان لم تشهده الثورة السورية من قبل، والفصائل العسكرية متقاربة كما لم تكن من قبل، والخطر محدق من التطبيع التركي وما سبقه من تقارب عربي مع الأسد وتطبيع أوروبي مرتقب، والفرصة كانت سانحة للانقضاض على الأسد المترهل الضعيف المشكوك به من حلفائه.
بَلَغني قبل بدء المعركة بستة أشهر من قادة في الفصائل التي شاركت في معركة ردع العدوان لاحقاً أن معركة حلب جدية وقريبة، ومع اقتراب ساعة الصفر أطلقت قيادة المعركة شائعات حول قرب المعركة على مدار ثلاثة أشهر. وعندما كان يسألني زملاء ومختصون في دراسات الحرب عن تلك الشائعات كنت أقول لهم إنهم يقدرون على حلب بالتأكيد، لكن لا أعرف متى ولا ما بعد حلب، وما الخطة إذا قرر النظام وروسيا سحق المنطقة بالبراميل والصواريخ.
تعتمد التفاصيل الواردة من التخطيط العسكري الدقيق للمعركة على أربعة عشر مصدراً بينهم قادة عسكريون من الصف الثاني من فصائل هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام والجيش الوطني وأنصار التوحيد، وجنديين وضابطين في قوات النظام برتبة رائد ونقيب، وثلاثة إعلاميين رافقوا المقاتلين في المعركة. وهذه المعلومات الحساسة تتقاطع بين ثلاثة مصادر على الأقل، وقد اطلعتُ على محادثات مجموعات واتساب خاصة بضباط النظام في حلب وريف إدلب وحماة، من الهواتف المصادرة أو التي تم الاستيلاء عليها من إدارة العمليات العسكرية.
سمحتْ العملياتُ الانغماسيةُ السابقةُ بدءَ معركة ردع العدوان لمقاتلي النخبة بمعرفة تضاريس المعركة وتوزع دفاعات النظام. وأدرك المقاتلون حقولَ ألغام على كامل خط النار المحيط بحلب، فصارت مهمةُ قوات النخبة وسرايا الحراري والعصائب التسللَ ورسم خريطة حقول الألغام. وقبل المعركة بأشهر بدأت عمليات التسلل ليلاً لتفكيك الصواعق في الألغام وإبقاء الألغام مكانها. كانت قوات النظام مطمئنة مع بدء المعركة لوجود حقول الألغام التي تمنع وصول أي قوات مشاة أو مدرعات.
نفذت هيئة تحرير الشام مخططاً استخباراتياً حين أوكلت لأحد قادتها من قبيلة البكارة التفاوضَ مع أبناء عمومته في “لواء الباقر”، وهو أكبر الألوية القتالية الرديفة لقوات النظام في مدينة حلب ويبلغ عدد مقاتليه ثلاثة آلاف مقاتل متفرغ ومثلهم من الاحتياط. بعد أشهر من التفاوض، تفاهم الطرفان على تقديم الأمان وبعض المكاسب للواء مقابل حياده وتقديم معلومات عن قوات النظام. وبالتزامن، أرسلت الهيئة ستة عناصر من العصائب الحمراء إلى المدينة قبل معركة ردع العدوان، استقروا في مقرات “لواء الباقر” مع ثلاث عربات مفخخة.
في أثناء هذه العملية، تلقت قيادة الهيئة مكالمةً من مجهول أبلغها أن أحد مقرّاتها العسكرية سيتعرض لغارةٍ روسية في ساعة محددة، ولم يُفصِح المتصل عن هويته ومصدر معلوماته. أفرغت الهيئة المقرّ الذي كان فيه نحو أربعين مقاتلاً، قبل أن تنسفه غارة روسية مدمّرة. توصلت الهيئة لاحقاً إلى الجندي المجهول الذي يقود مجموعة من قراصنة المعلومات المتطوعين العاملين من شمال غربي سوريا، اخترقوا هواتف ضباط في قوات النظام. أثناء عملي البحثي لتوثيق معركة ردع العدوان، قابلتُ هؤلاء الجنود المجهولين الذين كان لهم دور غير متوقع في المعركة، لكنهم أرادوا البقاء مجهولين.
في ثلاثة أشهر قبل معركة ردع العدوان نشرت قيادتُ الهيئة مجسمات مزيفة لمدفعية ودبابات على خط النار، بالتزامن مع نشر شائعات اقتراب المعركة، ما أربك قوات النظام بسبب زيادة عدد الأهداف الوهمية المعدّة للقصف. في هذه الأثناء كان الثوار يحفرون أنفاقاً وحفراً تتمركز فيها المدفعية الحقيقية وترمي أهدافها من فتحاتٍ مخفية، ولم يُنشر السلاح الحقيقي إلا قبل أيام من المعركة. كان نقل السلاح الثقيل ليلاً وخفية تحت غطاء إعلانات من شركات الكهرباء والاتصالات عن عمليات صيانة للشبكات وقطع الطرق في المنطقة حتى انتهاء نقل المعدات العسكرية.
كانت الليلة الفاصلة بين يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافقَين السادس والعشرين والسابع والعشرين من نوفمبر، ليلةً هادئة لا تختلف عن أي ليلة أخرى. كان الأهالي يرقبون الشوارع ليلاً منذ انتشرت شائعات الحرب في انتظار أرتال المقاتلين والسلاح التي تشير إلى جدية المعركة، ولكن لم يمرّ أحد، حتى استيقظ الناس في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي الساعة السابعة صباحاً على أصوات قصفٍ يميّزونه جيداً. قصف من جبهة الثوار. بدأت معركة ردع العنوان وبدأ النزوح الذي أعدّت إدارة العمليات العسكرية طريقَه مسبقاً. صُدم الأهالي النازحون على الطريق بإزالة المطبات في الطرق الرئيسية، وانقسام الطرق إلى نصف عسكري للإمداد والأرتال والإسعاف، وآخر للمدنيين.
اقتصرت المعركة في الساعات الأولى على منطقة قبتان الجبل في الزاوية الشمالية الغربية من مدينة حلب، وهي ذات تضاريس متعرجة وتلال صخرية تضمّ عشر بلدات سيطرت عليها إدارة العمليات العسكرية في نهاية النهار الأول من معركة ردع العدوان. كانت القوات المقتحمة من الجبهة الشامية وحركة نور الدين الزنكي وفرقة السلطان سليمان شاه، وهم فصائل في الجيش الوطني السوري المعارض بشارَ الأسد، ومعهم هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير والحزب الإسلامي التركستاني وحركة أحرار الشام وأنصار التوحيد. قُسّمت هذه القوات على خمسة محاور وعلى دفعات تتوالى في الهجوم تحت غطاء تمهيدي كثيف بالمدفعية والصواريخ، وشهدت متاريسُ النظام المحصنة اشتباكاتٍ عنيفة قُتل فيها أكثر من ثلاثين من الثوار. كانت خطةُ قوات النظام السماحَ للثوار بالوصول إلى المتاريس ليقعوا في حقول الألغام، لكن النظام لم يعلم أن الألغام غدتْ بلا صواعق، وضربت المسيرات الأهدافَ المعدّة مسبقاً مثل مدفعية النظام وتحصيناته الدفاعية في خط الجبهة وقطعت طرق إمداد قوات النظام.
كان الأهالي يترقبون انطلاقَ محورٍ آخر في سراقب أو ريف إدلب الجنوبي، متلهفين لمعرفة مدى المعركة، وهل هي لتحرير حلب فقط أم العودة إلى خريطة السيطرة قبل الحملة الروسية سنة 2019. في الساعة الواحدة ظهراً خرج المتحدث بِاسم إدارة العمليات العسكرية المقدم حسن عبدالغني بأول بيان عن المعركة معلناً “بدء عملية عسكرية لردع العدو ودحر قواته المحتشدة وإبعاد نيرانه عن أهلنا”. وبعد الحديث عن حرب النظام وإيران المفتوحة على الشعب السوري بحجة المقاومة التي اعتبرها “خديعة”، رفع يده اليمنى وقال: “إنها حرب معلنة”.
مع إعلان معركة ردع العدوان انطلق المحور الثاني جنوبي الأول، وسيطر الثوار على “الفوج 46” ومحيطه في معركة عنيفة قُتلَ فيها أكثر من عشرين من الثوار. كان الفوج أقوى تحصينات النظام في ريف حلب الغربي، لكن مقاتلي هيئة تحرير الشام عرفوا جيداً تفاصيل هذه التحصينات عبر خمس عمليات عسكرية خاطفة قبل المعركة. على أثر ذلك تشتت الطيران الحربي الروسي والسوري، فقد تغيرت الأهداف ونجحت خديعة المجسمات وتفوقت على قدرته سرعةُ التقدم وعدد المحاور الكثيرة ودفعات المقاتلين المتتالية على مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً، فكانت الغارات عمياء ولو لم تفارق سماء المعركة.
أسدل ليل اليوم الأول من معركة ردع العدوان على مئة وخمسين كيلومتر مربع محرر في ريف حلب الغربي. وتحت جنح الظلام تقدمت سرايا الحراري خمسة كيلومترات أخرى وتجاوزت بلدتي أورم وكفرناها، ووصلت منطقة خان العسل المتاخمة مدينةَ حلب وضاحية الراشدين، وودّعت الفصائل خمسين قتيلاً من مقاتليها وأصيب أكثر من ضعف هذا العدد.
أوحى بيان معركة ردع العدوان واسمها بغاية استباقية دفاعية، ولم يشهد الأهالي أرتالاً وحشوداً للفصائل كمعارك سابقة، ونقلت وكالة رويترز في الثامن والعشرين من نوفمبر عن “مصادر أمنية تركية” أن العملية ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في 2019. فُسّرت التصريحات بدعم تركيا العمليةَ، فتفاءل النازحون بالعودة إلى مناطقهم التي سقطت أثناء الحملة الروسية قبل الخامس من مارس 2020، لكن هذه التصريحات لم تبدُ أكثر من دبلوماسية تستند إلى اتفاقيات نسفها الروس والإيرانيون ونظام الأسد بالنار.
أكدت المصادر للفِراتْس أن الموقف التركي قبل أشهر من المعركة كان رافضاً للمعركة بحزم، وهدّد بإغلاق الحدود وعدم استقبال المصابين، وحمّل “تحرير الشام” كامل المسؤولية عن تبعات خرق وقف إطلاق النار. لكن أحد التيارين المتناحرين في المخابرات التركية كان داعماً المعركة وعلى تواصل مع المخططين عبر القيادي التركي في الهيئة عمر محمد جفتشي (المعروف أيضاً باسم مختار التركي)، وروّج لها في أنقرة على أنها الحل الوحيد المتاح وستحقق مكاسب كبيرة لتركيا، لكن التيار الآخر الرافض المعركةَ كان أعلى صوتاً إلى أن وصل الثوار مشارف مدينة حماة، فانقلب الموقف التركي بالكامل.
تفاصيل معركة ردع العدوان
في اليوم الثاني من المعركة، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر، وصلت قوات إدارة العمليات العسكرية إلى منطقة الزربة في ريف حلب الجنوبي وقطعت طريق حلب دمشق الدولي. ثم بدأت هجوماً على محورٍ جديد في محيط مدينة سراقب، ولكن النظام حشد في المدينة الاستراتيجية نخبة قواته وخصّص القوة الجوية للدفاع عنها، فواصلت قوات الثوار التقدم بوتيرةٍ أبطأ من اليوم الأول في محاور ريف حلب الغربي. امتدّ قطع طريق حلب دمشق الدولي من محيط سراقب إلى منطقة خان العسل، وبهذا التقدم بعمق اثني عشر كيلومتراً فقد النظام خطوط الإسناد الخلفية التي كانت فيها مرابض المدفعية والوسائط النارية وغرف العمليات الفرعية.
استمر الوضع على هذا المنوال ليلاً. وفي اليوم الثالث من “ردع العدوان” عندما كانت المعارك على أشدّها في أطراف مدينة سراقب، وتقدّم الثوار أكثر في ريفي حلب الغربي والجنوبي، حدثت المفاجأة في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم التاسع والعشرين من نوفمبر. اقتحم عناصر العصائب الستةُ، الذين كانوا يكمنون مع قوات “لواء الباقر”، اجتماعَ غرفة عمليات النظام المركزية في الشمال السوري في مبنى التدريب الجامعي داخل مدينة حلب، واشتبكوا مع الحرس ودخلوا المبنى السرّي وقاتلوا في الممرات وقُتل معظمهم إلا أن آخرهم وصل إلى غرفة العمليات ففجر نفسه. أسفر الهجوم عن مقتل قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في حلب الجنرال كيومرث بورهاشمي وضابط روسي (لم تصرّح المصادر عن هويته ورتبته بعد) وعدد من قادة قوات الأمن والجيش السوريين. وفي الوقت ذاته دمّرتْ مسيرات الشاهين برجَي الاتصالات الرئيسَين لقوات النظام في حلب، ثم بدأت مجموعة قراصنة البيانات اتصالاتها بضباط النظام تحضّهم على ترك السلاح والاستسلام.
شكلت ضربة غرفة العمليات وقطع الاتصالات والرسائل للضباط صدمةً مدويةً في قلوب قادة النظام في حلب، وبات التحرك للدفاع عن المدينة غير مركزي وبلا قيادة. فتحركت من الأكاديمية العسكرية الواقعة عند مدخل مدينة حلب عشرُ مدرعات ودبابات ومدافع مجنزرة إلى حدود المدينة ورُفعت سواتر لتشكيل خط دفاع عند دوار الموت (دوار أبي فراس الحمداني) ودوار السلام، وهما مدخلا مدينة حلب من جهة الغرب، لكن الوقت لم يسعف النظام. كان الثوار قد وصلوا إلى منطقة المنصورة والبحوث العلمية في الزهراء على بعد كيلومتر واحد من المدينة. ولاستثمار الصدمة والخلل في صفوف قوات النظام أرسلت الفصائلُ عربة مفخخة إلى دوار باب السلام، فنسفت خط الدفاع المنشأ حديثاً، وتقدمت عشراتُ المدرعات والعربات المصفحة التابعة للفصائل في دقيقتين تحت غطاء الدخان والغبار المنبعث من المفخخة لتدخل طلائعُ الثوار مدينة حلب في الساعة الثالثة عصراً من حي حلب الجديدة الذي استعصى على الثوار في معركة فك الحصار عن المدينة سنة 2016.
كانت الأحياء الأولى من مدينة حلب خالية من الدفاعات، ولم تطلق فيها طلقة وصولاً إلى ساحة سعد الله الجابري، باستثناء اشتباك في حي الأعظمية حيث يقع قصر الضيافة (قصر بشار الأسد في المدينة) ونادي الضباط. سقطت مدينة حلب من يد النظام. ففي ساعات قليلة انسحبت أفرع النظام ورمى الجنود مئات البنادق في الشوارع، وبعضهم هرب راجلاً إلى القطع العسكرية شرقي المدينة، وغنم الثوارُ أكثر من ثلاثين دبابة وعشرات المدرعات وقطع الأسلحة الثقيلة الأخرى ومستودعات فيها جميع أنواع الذخائر. سيطر الثوار أيضاً على مدينة سراقب في ريف إدلب بعد قتالٍ عنيف، إذ صارت المدينة مكشوفة وعلى مرمى أسلحة الثوار بالسيطرة على بلدتي كفربطيخ وداديخ المجاورتين اللتين دخل إليهما الثوار من أنفاق معدة مسبقاً فضربوا قوات النظام من خلفها.
بقيتْ في مدينة حلب وتخومها مواقعُ خارج سيطرة الثوار، وهي مدرسة المدفعية والأكاديمية العسكرية في الطرف الغربي من المدينة التي كانت تضمّ نحو ستّمئة ضابط معظمهم علويّون، اشتبكوا مع الثوار مراراً وتحصنوا في القاعدة العسكرية الضخمة والحصينة. وتمترست وحدات حماية الشعب التابعة قوات سوريا الديمقراطية في حَيَّي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية في الطرف الشمالي من المدينة، ثم تمددوا ليلاً إلى أحياء الهلك والشعار شرقاً وحي الخالدية غرباً على مدخل المدينة الشمالي عند دوار الليرمون.
اختارت إدارة العمليات العسكرية إدارة ملفّ وحدات الحماية بالتفاوض، أما الأكاديمية العسكرية ومدرسة المدفعية، فقد تواصلت مع الضباط لتسليم أنفسهم. ثم أحضرت حافلات في الليل وأخلت مئات الضباط إلى منطقة خناصر جنوب شرق حلب وسلّمتهم للنظام دون تصوير أو إعلان رسمي تفادياً لحالة انتقاد في أوساط الثوار. لكن هذه المعاملة للعلويين المؤيدين النظام الذين كانوا يتوقعون مشاهدة جثث أبنائهم وبناتهم في الأكاديمية، ترك أثراً إيجابياً وأنتج ثقة أن الثوار لن يقتلوا من يسلّم نفسه. اتصل الأهالي بأبنائهم في الجيش وطلبوا منهم تسليم أنفسهم إذا ما وصل الثوار إليهم، وهو ما ظهر لاحقاً في الأيام الخمسة التالية عندما صُدمت إدارة العمليات العسكرية بمشاهد انسحاب جماعية لم تكن متوقعة.
في الأيام التي تلت السيطرة على مدينة حلب، شنت الطائراتُ الحربية الروسية والسورية عشرات الغارات على مدينتَي حلب وإدلب وعدد من القرى والبلدات، وقبلها ارتَكبت مجزرة في مدينتَي الأتارب ودارة عزة حين بدأت المعركة. ومساء اليوم الثالث أصدرت “إدارة الشؤون السياسية”، التي كانت بمثابة وزارة خارجية غير رسمية لهيئة تحرير الشام، بياناً قالت فيه إن الثورة السورية لم تكن يوماً ضد أي دولة أو شعب بما في ذلك روسيا، وليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا البيان روسيا “إلى عدم ربط مصالحها بنظام الأسد أو شخص بشار، بل مع الشعب السوري، وإن الشعب السوري يسعى لبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كل دول العالم بما في ذلك روسيا التي نعتبرها شريكاً محتملاً في بناء مستقبل مشرق لسوريا الحرة”.
بالتزامن مع إصدار البيان السياسي الواضح والمطمئن، حلّق سربُ طائرات مسيرة في سماء حميميم دون أن يلقي قنابله. كان ذلك رسالةً تحذيرية لموسكو مفادها أن قاعدتها الجوية مكشوفة للنسخ الجديدة من الطائرات المسيرة القادرة على تدمير الأسطول الجوي الروسي. انخفضت وتيرة الضربات الروسية، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية سورية أن النظام تلقّى وعداً بوصول عتاد روسي إلى حميميم خلال ثلاثة أيام. فكشف هذا الإعلان عن عدم كفاية العتاد الروسي في سوريا، وعدم إمكانية وصول المساعدات قريباً. وفي الثلاثين من نوفمبر أعلن مستشار أردوغان أن الزعيم الوحيد الذي يجب على بشار الأسد أن يثق به هو الرئيس أردوغان، وأن “السبيل الوحيد لاستقرار سوريا ومخرجها من الأزمات هو التعاون مع تركيا”.
التزمت أنقرة بمسار أستانا الذي بدأ سنة 2017 وجمع روسيا وتركيا وإيران مع وفدين من النظام والفصائل السورية المعارضة، آليةً ناظمةً العلاقةَ والمفاوضات التركية مع النظام وروسيا وإيران، وغضّت الطرف عن خرق الاتفاقيات الكبير عندما سيطر الأخيرون على نصف المساحة الخاضعة لسيطرة الثوار سنتي 2019 و2020 وخسر الجيش التركي حينها نحو أربعين جندياً في إدلب. ولكن باتت أنقرة الآن أكثر حماسة للمعركة بعد السيطرة على حلب، ولم تعلن ذلك صراحةً خوفاً من بدء النظام وحلفائه حملة انتقام تدفع موجة هجرة جديدة إلى تركيا، ولذلك اتخذت موقفاً بعدم الضغط لوقف المعركة وتبني خطاب سياسي حذر.
صباح اليوم الرابع من معركة ردع العدوان، الموافق الثلاثين من نوفمبر، وفيما لم يستفق ضباط النظام وجنوده بعد من صدمة ضياع حلب من أياديهم، شاهد عناصر قوات النظام في ريف حلب الشرقي والجنوبي زملاءهم منسحبين أرتالاً وأفراداً متحدثين عن انهيار الصفوف. ومع هذا الانهيار وسرعة الهجوم وتفوّقه ورسائل التطمين ودعوات الانشقاق، تُظهر الرسائل التي اطلعت عليها الفِراتْس من هواتف الضباط المُصادرة لدى الهيئة أن نظريات المؤامرة تشكلت في صفوف قوات النظام أن روسيا تخلّت عن بشار الأسد وأن أنقرة ستكفل لموسكو بقاء القواعد. ولذلك أطلقت أنقرة هذه المعركة لتضغط على الأسد الرافض لقاء أردوغان، أو أن إسرائيل قررت إسقاط النظام كما فعلت مع حزب الله وأن إيران غير قادرة على إرسال جندي واحد. أدت هذه النظريات وما سبقها إلى قرار الانسحاب الجماعي من مواقع النظام العسكرية التي تجمّعت فيها كلّ القوات العسكرية التي انسحبت من حلب، وقد صدم هذا الانسحابُ الجماعي السريع إدارةَ العمليات العسكرية.
انسحبت قوات النظام من مطار حلب الدولي ومن عشرات المواقع العسكرية في الزاوية الجنوبية الشرقية إلى منطقة السفيرة حيث معامل الدفاع العسكرية، أكبر قطع النظام العسكرية في الشمال السوري. ومع وصول المنسحبين بدأ مسلسل الانسحاب بلا تنظيم، مع رفض الجنود أوامر قيادتهم بالثبات والتحصن، ثم أَبلغ الضباط زملاءهم في ريف إدلب، فاستمر الانسحاب الجماعي من قطعة عسكرية إلى ما بعدها وصولاً إلى ريف حماة الشمالي.
تحركت وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت شمالي مدينة حلب ووسعت سيطرتها على حساب قوات النظام المنسحبة شرقاً وسيطرت على مطار حلب الدولي ومواقع عسكرية في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة، ليطلق بعدها الجيش الوطني السوري معركة باسم “فجر الحرية” بمحورين جنوباً. أحدهما باتجاه مطار كويرس العسكري والمحطة الحرارية للسيطرة على ريف حلب الشرقي قبل انسحاب قوات النظام منها، والثاني إلى المنطقة التي باتت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الممتدة من تل رفعت إلى مطار حلب الدولي مروراً بالمنطقة الصناعية في الشيخ نجار. أما في إدلب فسيطرت قوات “ردع العدوان” على معرة النعمان وخان شيخون وكانت قوات الثوار تتقدم شرقاً وجنوباً بلا مقاومة كبيرة.
سيطر الجيش الوطني بعد معارك شديدة على مطار كويرس العسكري والفوج 111 والكلية الجوية ومساكن الضباط والمحطة الحرارية، ثم وصل إلى أطراف مدينة حلب من جهة الشرق وسيطر على مطار حلب الملاصق للمدينة بعد اشتباكات مع وحدات الحماية لتصبح الأخيرة محاصرة في عشرين بلدة بريف حلب الشمالي. واستولى الجيش الوطني على مئات الدبابات والعربات ومستودعات الذخيرة وراجمات الصواريخ ومنظومتي دفاع جوي روسيتين من طراز “بانتسير” المتطورة وعشرات صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
أكملت قوات عملية فجر الحرية تقدمها وصولاً إلى منطقتي دير حافر والسفيرة في ريف حلب الجنوبي، والتقت هناك مع قوات ردع العدوان القادمة من ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، وأكملت قوات الثوار في محور ريف إدلب الجنوبي تقدمها إلى ريفي حماة الشمالي والغربي. ثم خرج أحمد الشرع في بيان يدعو المقاتلين إلى الالتزام بالأمان المعطى لمن يسلّم سلاحه وبالإحسان للأسرى. قالت إدارة العمليات العسكرية إنها سوف تعلن في المرحلة المقبلة عن بدء عودة المهجرين في مخيمات النزوح إلى ديارهم وتوسعة المناطق الآمنة لضمان عودة كامل النازحين.
في اليوم الخامس، الموافق الأول من ديسمبر، أكمل الجيش الوطني السوري تقدّمه باتجاه منطقة تل رفعت شمالي حلب وتمكن من طرد وحدات حماية الشعب بعد اشتباكات شديدة. وكانت الأخيرة قد حصنت منطقة تل رفعت بشبكة أنفاق قدّر قادة عسكريون طولها بأكثر من عشرة كيلومترات. ثم قبلت الوحدات الانسحاب شرقاً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. أما جنوباً فسيطرت قوات الثوار على معامل الدفاع وخناصر، ليصبح خط المواجهة الجديد من أثريا شرقاً في البادية السورية إلى مدينة حلفايا غرباً، مروراً بمدينتَي صوران وطيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.
في خمسة أيام استعاد الثوارُ مساحاتٍ جغرافيةً استغرقتْ القواتُ الروسيةُ والإيرانيةُ نحوَ عامٍ ونصف العام للسيطرة عليها سنتي 2019 و2020، وكسرت قوات الثوار وقف إطلاق النار الذي حرصت الدول الفاعلة في سوريا على استدامته والدعوة إلى الالتزام به سراً وعلانية. وبعد سقوط حلب بدأت مجموعات المقاتلين المحليين من أبناء المناطق المهجرة المشاركة في معركة استعادة مناطقهم، وانضمّت إلى القتال تباعاً فصائل لم تكن ضمن إدارة العمليات العسكرية في اليوم الأول. وكسبت معركة ردع العدوان زخماً إضافياً في كل منطقة تنتزعها قوات الثوار من سيطرة الأسد والقوات الموالية له بانضمام مقاتلين من المناطق المُحررة إلى المعارك التالية.
شهد ريف حماة الشمالي منذ سنة 2013 خمس معارك حاولت فيها قوات الثوار إنهاء وجود نظام الأسد، لكنها فشلت جميعاً عند وصول المعارك إلى خط دفاع قوات النظام الحصين قرب مدينة حماة، المتمثل بجبل زين العابدين المطلّ على كامل المنطقة والذي تحيطه قطع عسكرية. تقع بلدة قمحانة التي باتت من أشهر البلدات الموالية للنظام السوري قرب الجبل، وإلى الغرب من قمحانة بلدة خطاب التي تحتوي على قطع عسكرية مع قربها من مطار حماة العسكري.
في اليوم السادس من معركة ردع العدوان، الموافق الثاني من ديسمبر 2024، رصّت قوات النظام صفوفها شمال الخط الحصين بمسافة خمسة عشر كيلومتراً، وبات خط المواجهة مع الثوار عند مُدن صوران وطيبة الإمام وحلفايا التي دارت فيها اشتباكات عنيفة استمرت لليوم الثاني، إلى أن سيطر عليها الثوار وانتقل خط المواجهة إلى جبل زين العابدين وقمحانة.
قالت مصادر عسكرية في هيئة تحرير الشام إن النظام السوري حشد في المنطقة “الفرقة 25 مهامّ خاصة” المدعومة روسياً، إضافة إلى الفرقة الرابعة واللواءين 105 و106 حرس جمهوري، ومجموعات مسلحة أفغانية توالي إيران كانت في سوريا لدعم الأسد منذ سنة 2013، إضافة إلى جزء من القوات المنسحبة من الشمال السوري وقوات من أفرع المخابرات. كل هذه الحشود تشير إلى أن معركة حماة أصبحت معركة الدفاع عن دمشق، لأن السيطرة على حماة ستفتح الطريق إلى العاصمة. فبعد حماة جنوباً يقع ريف حمص الشمالي، وهو منطقة حاضنة للثورة لا تزال فيها مجموعات من الجيش الحر تصل إلى مدخل مدينة حمص. وبعد حمص تكون المنطقة مفتوحة إلى القلمون والغوطة الشرقية، ويمكن الوصول إليها بسهولة من البادية السورية. نشرت قوات النظام في مواجهة هذا التحدي دعواتٍ لاستقطاب الشباب للقتال على الجبهات براتب خمسة ملايين ليرة سورية، بلا أي استجابة.
هيئة تحرير الشام
أسهم بشار الأسد بنفسه في انخفاض جاهزية قواته لمواجهة معركة ردع العدوان، فلم تدفع الفرقة 25 مهامّ خاصة أياً من قواتها في معركة حلب. الفرقة التي كان يقودها سهيل الحسن الملقب بالنمر حتى ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الخاصة في أبريل 2024 وتعيين اللواء صالح عبد الله خلفاً له. يقع مقر قيادة الفرقة شرقي جبل زين العابدين. كانت الفرقة تعاني من الترهل الذي أصاب الجيش السوري قبل تغيير قيادتها، وجاءت التعيينات الجديدة وتبديل بشار الأسد المناصبَ بين القادة العسكريين في شهري أبريل ومايو 2024 لتفاقم من هذا الترهل. كان هدف بشار هو منع تكوّن أية تكتلات عسكرية متينة قد تشكل خطراً عليه في ظلّ التطورات الإقليمية بعد حرب لبنان، لكن هذه التبديلات تسببت في تفكك الألوية المقاتلة ووقوع خلافات كبيرة بين قياداتها، مثل الخلاف الذي دبّ بين النمر وعبد الله، والذي سجلته المحادثات النصية التي اطلعنا عليها في الهواتف المُصادرة لضباط جيش النظام، ثم أكدته للفِراتْس مصادر عسكرية خططت وقادت معركة ردع العدوان.
في اليوم السابع من المعركة، الموافق الثالث من ديسمبر، ظهر التوتر في النبرة السياسية لحلفاء النظام. في إيران اتهم مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي تركيا بالوقوع في”الفخ الإسرائيلي الأمريكي”، وأظهرت التصريحات العراقية أن بغداد تجاوزت دورها وسيطاً وزادت مؤشرات إرسال قوات من فصائل الحشد الشعبي، وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن اجتماعاً بشأن سوريا سينعقد في الدوحة يومَي السابع والثامن من ديسمبر على هامش منتدى الدوحة، إلا أن الخارجية القطرية نفت ذلك.
كانت المعارك في الثالث والرابع من ديسمبر ضارية في محور جبل زين العابدين، وقُتل فيها عشرات الثوار حتى سيطروا أخيراً على بلدة معرشحور شرقي جبل زين العابدين وجبل كفراع الملاصق له وهو أصغر وأخفض منه، وكذلك مقر الفرقة 25 في مدرسة المجنزرات، ورحبة خطاب. وتقدم الثوار ليلاً من بادية خناصر إلى باديتي أثريا والرهجان ثم إلى بادية السعن شرقي حماة وأكملوا تقدمهم في البادية السورية وصولاً إلى شرقي معرشحور في بادية السلمية، ثم وصلوا بلدة المباركات الملاصقة للجهة الشرقية من مدينة حماة بعد أن سيطروا على اللواء 87، وتعرّض هذا المحور لعشرات الغارات الجوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام.
ردع العدوان
تواترت حشود النظام العسكرية من القوات النظامية والمجموعات المسلحة الرديفة لها إلى المنطقة، وعوّل النظام كثيراً على خط الجبل قمحانة، ولذلك اعتمد قادة معركة ردع العدوان خطةً بديلةً كانت قاضية بناءً على معلوماتٍ استخباراتيةٍ دقيقة. أعلنت إدارة العمليات العسكرية عبر قنواتها الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي استهدافها اجتماعاً لقادة النظام الأمنيين والعسكريين، وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة اللواء سهيل الحسن وقائد “قوات الغيث” العميد غياث دلة، في معسكر الطلائع في الشيخ غضبان قرب مدينة مصياف في ريف حماة الغربي بطائرة مسيرة ضربت الغرفة التي يجتمعون فيها، ثم انهالت المسيرات على أهداف كثيرة فدمّرت عشرات الآليات العسكرية في جميع محاور حماة ولاحقت مجموعات النظام وقتلت العشرات منهم.
ومع وصول المعركة إلى تخوم القرى العلوية في ريف حماة الغربي، ولحضّهم على عدم المشاركة في معركة حماة، نشرت إدارة الشؤون السياسية عبر قناة تواصلها في تطبيق تلغرام بياناً موجهاً إلى الطائفة العلوية دعت فيه إلى “طيّ صفحة الآلام” وإلى “سوريا المستقبل موحدة بأبنائها جميعاً” ودعتهم إلى “فك أنفسهم عن هذا النظام”. ودخل الثوار مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة الغربي بلا قتال وبعد اتفاق وتطمينات لأهلها في الخامس من ديسمبر، وكذلك مدينة السلمية ذات الغالبية الإسماعيلية شرقي حماة.
في اليوم التاسع الموافق الخامس من ديسمبر، وصل الثوار المتقدمون من محور البادية إلى شرقي مدينة حماة. وبينما انشغل النظام بالدفاع عن جبل زين العابدين وقمحانة وحاول صدّ التقدم في محور خطاب، باغته الثوار من المحور الجديد شرقي المدينة والتفوا على الجبل. وتحت أجنحة مسيرات الشاهين تقدم الثوار إلى الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة في المزارب ودخلوا حَيَّي الأربعين والقصور. ومن الزاوية الشمالية الغربية دخلوا حَيَّي كازو والبرناوي، فانهارت قوات النظام وانسحبت على عجالة من المدينة ومطارها العسكري برتلٍ طويل إلى حمص وريف حماة الغربي ذي الغالبية العلوية. وبذلك حوصر جبل زين العابدين وبلدة قمحانة، فاستسلمت قوات النظام فيهما عبر اتفاق على فتح الطريق إلى الساحل السوري.
كانت معركة حماة قاسية في الجانبين، تعامل معها النظام باعتبارها معركة دفاع عن دمشق والساحل، وتعامل معها الثوار على أنها بوابتهم إلى حمص ودمشق. كانت معركة حماة رهان على قدرة النظام على تجميع صفوفه بعد انهيارات حلب، وقد خسر الرهان. كان للمسيرات دور مهم في المعركة، ثم كانت الخطة المفاجئة القاضية من محور البادية. وفي مباركة الجولاني لأهالي حماة أعلن لأول مرة رسمياً عن اسمه في نهاية البيان قائلاً إنه أحمد الشرع.
غصّت شوارع مدينة حمص، في ليلة تحرير مدينة حماة، بأرتال من سيارات مدنية وعسكرية تحمل الهاربين إلى الساحل السوري، وانسحبت القوات الروسية من مواقع متفرقة في المنطقة الوسطى والبادية السورية، في حين اختنق طريق حلب دمشق الدولي بأرتال الأهالي القادمين من الشمال السوري إلى المناطق المحررة الجديدة ومدينة حماة. وارتدى المقاتلون القدماء من الثوار الذين اعتزلوا القتال منذ سنوات جعبهم، وانطلقوا للمشاركة في تحرير ما تبقى من سوريا، وكذلك فعل آلاف المدنيين الذين انضموا للمشاركة. وفي ريف حمص الشمالي انتفض ثوار مدينتَي تلبيسة والرستن اللتين خضعتا لاتفاقية تسوية ومصالحة منذ سنة 2018 وهاجموا حواجز النظام، وقصفت الطائرات الروسية جسر الرستن الإستراتيجي بثماني غارات لم تكن كافية لتدميره، ولكن الغاية كانت إبطاء تقدم الثوار إلى مدينة حمص.
في اليوم العاشر الموافق السادس من ديسمبر، ومع ساعات الصباح الباكر، بدأ ثوار درعا مهاجمة مواقع النظام في المحافظة. وسيطر الثوار بعد حماة على مدن وبلدات الرستن وتلبيسة وتير معلة والدار الكبيرة في ريف حمص، وأعلن الشرع أن هدف المعركة هو تحرير دمشق وإسقاط النظام. فيما أعلنت المجموعات الثورية المحلية في محافظة درعا تشكيل “غرفة عمليات الجنوب” التي أطلقت معركة “كسر القيود”، وأعلنت مجموعات أخرى في ريف درعا ودمشق عن تشكيل “غرفة فتح دمشق”، وتحركت مجموعات محلية في السويداء للسيطرة على مواقع النظام العسكرية.
سيطر مقاتلو الجنوب على أكبر قطع النظام العسكرية وحواجزه تباعاً، وسقطت قطع عسكرية كبيرة وحواجز رئيسة بعد اشتباكات وقع فيها قتلى من الثوار، وشارك فيها طيران النظام ومدفعيته. وبعد ساعات العصر بدأ الانسحاب الجماعي لقوات النظام نحو دمشق، وقبل منتصف الليل انسحب رجل النظام الأول في محافظة درعا العميد لؤي العلي نحو دمشق. وفي رسالة مصوّرة بثتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت غرفة عمليات الجنوب “درعا حرة”. وفي ساعات استعاد مقاتلو درعا مساحةً أكبر من المناطق التي خسروها أمام الحملة الروسية سنة 2012. بقي للنظام ريف درعا الشمالي، وأعلنت غرفة عمليات الجنوب في الرسالة المصورة نفسها أن وجهتها دمشق.
مع انسحاب القوات الروسية من جنوب البلاد واقتراب الثوار من حمص ودمشق، حثّت موسكو رعاياها على مغادرة سوريا وأعلنت بغداد وقوفها إلى جانب الشعب السوري وسيادة سوريا، وقال أردوغان إنه يأمل أن يستمر زحف الثوار السوريين نحو حمص ودمشق دون أي مشاكل. ثم تحرك جيش سوريا الحرة من قاعدة التنف تحت غطاءٍ أمريكي غير مُعلن فأغلق الحدود العراقية ووصل إلى مدينة تدمر وبلدة القريتين، شرق حمص، لمنع استغلال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في البادية السورية ما حدث. وهذا ما ساهم بحماية الخاصرة الشرقية للثوار. ثم انسحبت قوات النظام وجماعات إيران المسلحة من مدينة دير الزور وريفها إلى العراق، لتحلّ محلها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وتحرك الثوار المحليون في المنطقة للسيطرة على المدينة.
في اليوم الحادي عشر للمعركة الموافق السابع من ديسمبر، وبينما يتسارع انهيار النظام، عُقِد اجتماع الدوحة بمشاركة قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق مع دول أستانا الثلاث تركيا وروسيا وإيران، وأصدروا بياناً لا يحمل أي اتفاق. في هذا المنتدى اقتنع حلفاء النظام أنه قد سقط وتجاوز مرحلة الإنقاذ.
استكمل ثوار الجنوب السيطرة والتقدم على مواقع النظام التي انسحب منها، وأُعلنت محافظات درعا والسويداء والقنيطرة مناطق محررة مع ساعات العصر. ومع وصول الثوار الذين التفوا من بادية حمص إلى تخوم منطقة القلمون، أعلنت إدارة العمليات العسكرية تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق. وبدأت تتوارد أخبار انسحاب قوات النظام من محيط دمشق، ووصل الثوار من ريف درعا وريف القنيطرة الشمالي إلى منطقة “مثلث الموت” وكناكر وسعسع وزاكية وخان الشيح ودير خبية والكسوة في ريف دمشق الغربي. وسيطروا على داريا ومعضمية الشام المتاخمتَين لمطار المزة العسكري، مع تحرك مقاتلي الجيش الحر الذين بقوا في هذه المناطق بعد تسويات سنة 2018 وما سبقها. ومع ساعات المساء انسحب حاجز “منكت الحطب” من مدخل دمشق الجنوبي، وبدأ ثوار درعا التقدم باتجاه مدينة دمشق. وفي الغوطة الشرقية انتفض الأهالي بلا سلاح وطردوا قوات النظام التي كانت تتحضر للانسحاب، وكذلك تحرك المقاتلون المحليون في بلدات القلمون مع انسحاب قوات النظام من عشرات القطع العسكرية في المنطقة. ومع ساعات المساء أمسى الطريق مفتوحاً نحو مدينة دمشق من جنوبها وشرقها وغربها وشمالها.
شهدت ساعات النهار معارك على تخوم مدينة حمص، وقاومت قوات النظام في الكلية العسكرية القريبة من حي الوعر بمشاركة الطيران الحربي. توقفت المعارك ظهراً وبدأت المفاوضات. وقبل منتصف الليل، انسحبت قوات النظام والجماعات المسلحة الموالية لها وقوة الرضوان التابعة حزبَ الله اللبناني من مدينة حمص ومحيطها.
مع الدقائق الأولى من ليلة اليوم الثاني عشر الموافق الثامن من ديسمبر، دخل الثوار مدينة حمص ووجدوا الآلاف من أهالي مدينة حمص يتواترون إلى الشوارع والساحات محتفلين بحرية مدينتهم. انسحبت قوات النظام وحزب الله اللبناني من مدينة القصير، فأكمل مقاتلو الفصائل المهجّرون من مدينة القصير طريقهم إلى مدينتهم. وصل إلى محيط حمص آلاف المقاتلين المتطوعين، ولم يستطع كثيرون الخروج من الشمال للمشاركة في المعركة لأن الوقود في الشمال السوري نفد بسبب زيادة الطلب الكبير عليه من الأرتال المنطلقة إلى الجنوب.
وصل الثوار إلى شنشار جنوبي مدينة حمص، لكن الطريق الدولي في الاتجاهين كان مكتظاً بأرتال الهاربين من دمشق وحمص، مدنيين وعسكريين ومؤيدين إلى الساحل السوري. فسَمح الثوار لغير المسلحين منهم بإكمال الطريق وانتزعوا السلاح من الضباط والجنود. ووصل مسلحون محليون إلى سجن صيدنايا العسكري بعد الاشتباك مع آخر حواجز النظام وانسحاب البقية. وبعد ساعات من الاشتباكات والمفاوضات، فتحوا باب السجن وحرروا المعتقلين، ووصل ثوار الغوطة الشرقية المهجّرون إلى مدنهم قادمين من الشمال السوري عبر البادية.
خرج بشار الأسد من دمشق إلى قاعدة حميميم ومنها إلى روسيا، وأوعز ضباط الجيش لجنودهم أن النظام سقط، وشاهد الدمشقيون من نوافذهم جنود الأسد يرمون أسلحتهم في الشوارع ويطرقون الأبواب طلباً للباسٍ مدني. وفي الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة فجراً، أعلنت إدارة العمليات العسكرية رسمياً، عبر قنواتها على وسائل التواصل، دخول قواتها العاصمةَ دمشق. وفي الخامسة فجراً صعد شبان يهتفون فرحاً على دبابة متروكة وسط ساحة الأمويين، وركنت أربع صبايا سيارتهنّ قربها على صوت عبد الباسط الساروت يغنّي “جنّة جنّة جنّة.. جنّة يا وطنّا”، مُعلنين سقوط الأسد ونظامه قبل دخول أي مقاتلين من الفصائل إلى العاصمة.
صحفي سوري وباحث في الشؤون العسكرية
مجلة الفراتس
————————————-
ليلة كوميديّة سورية/ فدوى العبود
08-فبراير-2025
تولد الفكاهة من لا معقولية الواقع ومفارقاته، وهي في رأي الكثيرين خط الدفاع الأخير عن حرية الإنسان ورغبته في مقاومة سطوة السلطة على تنوعها، إذ “تعكس، بحسب موريل، تحولًا من الشعور بالعجز والنقص إلى الإحساس بالتفوق، ورفض الاستسلام، وقدرةً على التحرر من أسرِ الأسى”.
لكنّ الأسى الذي اختبره السوريون على مدار نصف قرن من حكم الأب، يليه الابن، جعل العقد الأخير ليس فقط الأكثر دموية، مما يطيق إنسان احتماله، بل أيضًا أشدها سريالية. فالقمع والرقابة والخوف وإيقاف عقارب الزمن عند الأبدية (وهذه حكاية أخرى)؛ جعل الفكاهات بلا روح وحوّلها إلى شيء مغاير.
إذ فقدَ الواقع منطقّيته، وتأقلم الإنسان السوري مع سرياليته، وبدا كل خارج عن المألوف طبيعيًا. فامتد القمع من لغة السوري إلى كيانه العميق، وحُجبت عنه روحه الحرة. قُلّمت فكاهاته، ونُزع عنها فتيل قوّتها، وحلّت فيها روح هدامة افتقرت لقوة الموقف الأخلاقي، وغدت تعبر عن جفافٍ روحي ووعي مشوه.
وفي حقبة الأب، كانت النكتة اللمّاحة كفيلة بأن تودي بصاحبها، أما في عهد الابن فقد انصبت السخرية على شخصيات النظام، والتي كان أغلبها يتسم بالبلَه والجرأة. فهذه الدمى الهزلية، التي تنوعت مواقعها (محلل سياسي، عضو في البرلمان، إعلامي، جنرال حرب)، كان يجمعها: جهلها باللغة، إذ ينصبُ أحدهم الفاعل ويرفع المفعول، أو يصيغ عبارة غير مفهومة، أو يجافي عبر منطق أعوج الواقع الحقيقي.
ولم يكن وجود هذه الشخصيات سوى طريقة بدت وكأنها تؤدي دورًا في مسرحية هزلية أمام شعبٍ اعتبره -الأخ الأكبر- مجموعةً من الأطفال القُصّر. وقد نجحت، رغم هزالها الإنساني، في حرفِ الأنظار عن الواقع السياسي المرير.
فبدت الأخطاء الساذجة لهؤلاء كمخرج وحيد لواقع سياسي مسدود، وتبديدًا لقوة النكتة، وتعميقًا وتعزيزًا للخوف والتيه الذي وجد السوريون أنفسهم عالقين فيه.
الفكاهة بعد سقوط النظام
وفي الأيام التي أعقبت سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الثاني/ديسمبر 2024، ومع تنفس أولى نسائم الحرية، استعادت الفكاهة ألقها، وحاولت أن تسترجع شيئًا من روحها، إذ انصبت على الرئيس المخلوع ومشهد فراره المخزي. ثم أصبحت شخصياته الهزلية موضع سخرية؛ ولعل أبرزها قائد قوات الفرقة 25، سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر”.
وفي هذا السياق، كانت الفكاهة وسيلة للتحرر عبر إدراك ضآلة الطغاة، الذين يُثبت الزمن أنهم لم يكونوا آلهة، بل فزّاعات من القش.
لذلك، لم تكن الحالة الهستيرية التي عاشها قسم كبير من السوريين ليل الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2025، بعد نشر يوتيوبر عبر قناته ذات المحتوى الساخر إشاعة تشير إلى تسليم الساحل السوري لماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، وإنزال مظليّ لقوات “النمر” فوق جبل زين العابدين، حالةً طارئة، بل امتدادًا لعقودٍ من الخوف.
جعلت هذه الإشاعة قسمًا من السوريين، وبعض مؤيدي السلطة السابقة، يسارعون للاحتفال، بينما بادر آخرون لإطلاق النار ابتهاجًا بعودته، إلى أن انقلب الحال مع إدراكهم أنهم وقعوا ضحية مزحة تحولت إلى جد.
المزاح في ظل الاستبداد
يبدأ الأمر بالهزل والضحك، وينتهي بتدمير حياة إنسان: هذا ثمن المزاح في ظل أنظمة شمولية تُفقد الإنسان القدرة على التفريق بين الجدّ والمرح. فالإنسان الذي يعيش في ظل استبداد مديد يعلم أن مزحة واحدة قد تودي بحياة إنسان.
وفي النهاية، انتهى المشهد بانقلاب الذين سارعوا للاحتفال على أنفسهم، إذ راحوا يهتفون للقيادة الجديدة. هذه الحادثة، رغم خفتها وظرافتها برأي كثيرين، كانت في مجملها مجرد حكاية حزينة، إذ أظهرت أن الجرح أعمق مما نعتقد، وكشفت عن الرضّ النفسي الذي عاشه السوريون، فأفقدهم القدرة على التمييز بين الحدود، وضاعت المعالم الواضحة في حياتهم بين المعقول واللامعقول.
لم تعد المخيلة السورية تجاوزًا للواقع، ولا “علامة على العظمة” كما اعتقد بودلير، بل علامة على التعاسة اللا محدودة.
هذه التعاسة التي اختزلها الأسد في تحويل نصف البلاد إلى مقبرة، ونصفها الآخر إلى سجن يقيم بين أسواره رهائن فقدت فكاهاتهم أجنحتها، ليتحولوا هم أنفسهم إلى فكاهة.
الفكاهة في ظل الطغاة
في أحد كتبه، يورد كونديرا قصة لستالين الذي قرر ذات يوم أن يذهب للصيد: “ارتدى معطفًا رياضيًا قديمًا، حمل على كتفه بندقية طويلة، واجتاز ثلاثة عشر كيلومترًا. عندئذ، شاهد أمامه طيور الحجل، فتوقف وعدّها فوجدها أربعة وعشرين طائرًا. لكن يا لسوء الحظ، لم يأخذ معه إلا اثنتي عشرة طلقة. أطلق النار فقتل منها اثني عشر طائرًا، ثم عاد ليقطع ثلاثة عشر كيلومترًا نحو منزله، وأخذ اثنتي عشرة طلقة أخرى، واجتاز الكيلومترات الثلاثة عشر مرة أخرى، ليجد نفسه أمام الطيور ذاتها، لم تزل واقفة على الغصن نفسه. أطلق النار عليها، فقتلها جميعًا”.
حين روى ستالين لمرافقيه ومستمعيه قصة طيور الحجل، لم يضحكوا. نظروا إليه بوجوه متشنجة؛ لأنّ أيًّا منهم لم يكن يعرف ما هو المزاح.
فقدان المعنى
لم يستوعب السوريون معنى الفكاهة، فقد فرغت عقود من الخوف -الذي تلاه يأس- أرواحهم من قدرتها على الهدم والتفكيك. وكشفت الحادثة الأخيرة أن الطغاة، رغم تشابه أساليبهم، يثيرون الدهشة لا الإعجاب. فضررهم لا يقتصر على اللغة وبنى التفكير، بل يمتد ليخلق أعتى أنواع اليأس.
تختزل القصة الأخيرة الوجه الأكثر فجائعية للنكتة السورية. إذ لم تكن ليلة الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير حادثة كوميدية، بل فصلًا من مسرحية تراجيدية طويلة، بطلها الإنسان السوري، الذي عانى عقودًا من الخوف جعلت فكاهاته ذات الطابع الهزلي تتغذى على اليأس، وهو الأخير مولّد الأوهام.
لا يمكن لإشاعة عودة طاغية عبر إنزالٍ مظليّ أو بساط ريح أن تضحكنا، لأنها تبدو تجسيدًا دقيقًا للعبارة التي كتبها أحدهم ذات يوم:
“إذا حدقت في نكتة لوقتٍ طويل، ستبكي كثيرًا.”
الترا صوت
———————————–
عندما كانت تماثيل الأسد أدوات لاستبداده/ مالك ونوس
08-فبراير-2025
كنا صغارًا عندما بدأ ذلك الجبل فوق السهل الفسيح مقابل قريتينا يظهر، الجبل الذي سيقام عليه تمثال حافظ الأسد، مؤسس جمهورية الخوف في سوريا. كنا نقف على سطح منزلنا أو فوق الجرف الصخري المطل على البحر ونراقب بدهشة عملية ظهور الجبل وارتفاعه يومًا بعد يوم، ونتساءل: “هل هكذا تشكلت الجبال عبر التاريخ؟”. كما كنا نستغرب كيف كانت الشاحنات تراكم الصخور والأتربة التي تخرج من المنطقة التي سيشاد عليها معمل الإسمنت على السهل الزراعي الذي كان ينتج الخضار، بدلًا من رميها في البحر وزيادة مساحة اليابسة، كما كان يقترح بعض الأهالي والمختصين يومها، لكن يبدو أن النظام كان لديه رأي آخر. لم يَطُل الأمر طويلًا حتى اكتمل بناء الجبل مع اكتمال تجريف الأرض التي أخذت تأتيها ورشات بناء الصوامع العالية المخيفة، بينما صار ذلك الجبل جاذبًا لنا نحن الصغار الذين كنا نسمع عنه القصص الجميلة عما سيكونه، حول الحديقة والمقاعد والمطعم ومدينة الألعاب التي ستكلل قمته.
لم يتأخر الوقت كثيرًا حتى جاء مشروع الطريق السريع الذي يصل مدينة طرطوس باللاذقية، والذي اخترق الجبل الجديد، وأخذ يقضم منه كميات كبيرة من التراب والصخور لاستخدامها في هذا المشروع فلم يتبقَّ منه سوى كتلة صغيرة؛ جبلٌ صغيرٌ لا يمكن أن تقام عليه مدينة ألعاب أو حتى مقهى صغير فأخذت فرحتنا تذروها الريح. أما وقد اكتمل بناء معمل الإسمنت ودخل في طور الإنتاج، فقد تفرغت العقول النيرة للتفكير، وتفتقت في النهاية عن فكرة مشروعٍ، أثار الأسئلة في البداية، ثم أدخل الحسرة والغم في قلوب أهل المنطقة، عندما سمعوا أن تمثالًا ضخمًا لحافظ الأسد سيقام على بقايا الجبل، وربما سيكون أضخم من تمثال مدينة دير عطية في ريف دمشق الشمالي.
كانت المدن تتنافس يومها على إشادة التمثال الأكبر للزعيم المؤبد، على الرغم من أن البلاد كانت قد دخلت في العزلة عن المحيط العربي والعالم بعد الجرائم التي اقترفها نظام الأسد بداية ثمانينات القرن الماضي، حين ارتكب المجازر في حماه وحلب وإدلب وسجن تدمر، وبسبب دعمه لإيران في حربها مع الشقيق العربي؛ العراق. انعكست العزلة حصارًا اقتصاديًا على النظام الذي تمتع بالدعم العربي السخي بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وبعد دخول جيشه إلى لبنان أواسط سبعينيات القرن الماضي، بموجب قرار عربي. ثم جاءت حادثة محاولة تفجير طائرة “إل عال” المتجهة من لندن إلى تل أبيب، والتي أتُّهِمَ النظام السوري بالتخطيط لها سنة 1986، لتزيد من تلك العزلة وتنعكس على اقتصاد البلاد. الآن وقد انقطع ذلك الدعم، ودخلت سوريا في طور أزمة اقتصادية عميقة، تساءل كثيرون في سرهم، أو همسًا في أذان بعضهم: “إذا كنا لا نجد قوت يومنا، من أين سيأتي نظام الأسد بالأموال لإشادة تمثال يرتفع عشرات الأمتار ويكلف أموالًا هائلة، ستذهب لإقامة قاعدة عميقة بأعمدة تخترق الجبل الهش وتصل إلى المنطقة الصلبة تحت الجبل لتحمل عشرات الأطنان من الحديد والإسمنت التي ستشكل هيكل التمثال؟”.
انتهى بناء التمثال وأصبح بيديه المرفوعتين كأنه يريد أن يقول أنا أهيمن عليكم، لذلك كنا نشعر أنه أداة أخرى من أدوات القمع التي يستعملها حافظ الأسد لإدامة حكمه. إن عجز عسسه عن مراقبتنا كنا نشعر أن التمثال يراقبنا حيث ذهبنا؛ ينظر إلى قريتنا التي تتموضع فوق الجبل المطل على البحر فتدخل نظراته إلى نوافذنا فيرانا، وربما يسمع ما نقول. يرانا على أسطح منازلنا وفي طرقات القرية، وكان يرانا ونحن ننحدر نحو الحقول التي نزرعها جانب البحر. كيفما ولينا أوجهنا هو أمامنا؛ لا تفارق نظراته أجسادنا ولا أذنيه حركات شفاهنا. كانت الفاقة قد دخلت إلى جميع البيوت، فكان الحديث عن الأموال التي صرفت من أجل تشييده. كان أبي أكثر المتبرمين منه، أطلق عليه تسمية “قاموع الخر…”، وكان يسأل دائمًا: “متى سيسقط هذا القاموع؟”.
كان التمثال يكشف معمل الإسمنت ومساحة واسعة من السهل، وكان سكان القرى شمال قريتنا يرونه على بعد 10 كيلومترات. كان الجميع يشعر أن التمثال يراقبهم، بل يكشف كل من يحمِل في قلبه حبًا زائفًا للقائد. أعطى التمثال طاقة لبعثيي المنطقة، ورجال الأمن المتخفين على شكل كتّاب تقارير أمنية منتشرين بين أزقة القرية وفي ساحاتها، في المدرسة والمصنع والمؤسسة والنقابة والملعب والمقهى والطرقات والحدائق وفي وسائل النقل. كان التمثال ممثلًا للقائد؛ ثبات التمثال هناك في أعلى التل، هو ثبات للقائد في كرسيه في دمشق، وكانت صلابة الإسمنت فيه صلابة لعسس القائد الذين يَفْدونه بدمائهم وأرواحهم.
حين اندلعت ثورة السوريين ضد حكم الوارث بشار، بدأ هذا في تفكيك بعض التماثيل التي تعود لوالده لأن ذلك كان مطلبًا من مطالب الثوار، وربما خوفًا من تكسيرها إذا ما خلعت المدن الثائرة بشار وهجمت على تماثيل أبيه. تنسَّمنا الأمل أن يأتي دور التمثال الذي يراقب قريتنا والقرى المجاورة فيُزال، لكن آمالنا لم تتحقق، كان علينا أن ننتظر 14 سنة لكي يتحقق حلمنا. وحين أتى هذا اليوم، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، كانت تماثيل حافظ الأسد في المناطق التي كانت تحت سيطرة بشار، أولى أهداف الناس، كانت تنتقم من التماثيل بعدما عجزت عن الانتقام من الأب القائد والابن الوارث.
ففي الساعات الأولى للإعلان عن سقوط النظام وهروب الرئيس المخلوع بشار الأسد، توجه عدد من أهالي مدينة طرطوس إلى مبنى فرع حزب البعث المنحل بجانب شاطئ المدينة، المبنى المهجور والآيل للسقوط بسبب الفساد الذي رافق أعمال بنائه، وهناك كسَّروا تمثالًا نصفيًا لحافظ الأسد. ثم توجهوا إلى مدخل المدينة الجنوبي، حيث التمثال الكبير، من أجل رميه وتكسيره أيضًا، لكنهم فوجئوا بتجمعٍ غفيرٍ من فقراء حي الرادار العشوائي القريب، كانوا يعملون على إزالته، أما سبب المفاجأة فهي أن قسمًا من هؤلاء حال دون إزالة هذا التمثال سنة 2011، حين أزيلت تماثيل أخرى، لكن يبدو أنهم احتاجوا 14 سنة لكي يكتشفوا حقيقة بشار الذي خدعهم وأدار لهم ظهره هاربًا. أما التمثال الذي نغص عيشنا في القرية فقد احتاج إلى آلة كبيرة من نوع “النقّار” الذي ظل يعمل يومين أسفله حتى تمكن من أحداث فجوة فيه سقط بعدها على أرض التل، كأنه يقول: “وفي هذه أيضًا سأعذبكم”.
الترا صوت
————————-
بماذا فكّر بشار الأسد أثناء هروبه؟/ حاتم علي
السبت 8 فبراير 2025
يُنشر هذا النصّ ضمن “لنتخيّل”، وهو ملفّ مفتوح يضم نصوصاً، مدوّنات، قصصاً، مقابلات وتقارير صحافيةً نتخيّل من خلالها المستقبل الذي نوّد أن نعيش فيه، أو ذلك الذي سيُفرض علينا.
ينتعل السيد الرئيس حذاءه، يباشر “عمله” ليباشره شقيقه ماهر: “لقد دخل الإرهابيون حلب”، يكمل خطواته إلى مكتبه وهو لا يشعر بحذائه تحت قدميه، يشعر بالقصر يدور حوله، يأخذ حبتين من ظرف “البنزوديازبين” المهدئ للقلق، يشرب الماء من زجاجة مختومة، يغط في نومٍ عميق ورأسه على طاولة مكتبه. يوقظه ماهر مجدداً: “لقد أصبحوا على أبواب مدينة حماة”، ينظر إلى أخيه ووجهه منتفخ من النوم، وعليه آثار الأقلام والأوراق والتقارير والكتب التي كان وجهه نائماً عليها.
يقف وينظر إلى صورة أبيه المعلقة على الحائط، ليأتيه خيال والده: “افعل ما فعلته أنا في حماة”. ينظر الابن ملتبساً يتقمص كاريزما أبيه، ويوجه أمراً للضباط الكبار: “قاتلوا حتى الموت، سأبعث بكل الدعم… الدعم قادم”. كان الخوف يأكله، يعرف في قرارة نفسه أنه ضعيف، ولولا الوفاة المفاجئة لأخيه باسل لكان مجرد أخٍ هامشيّ للرئيس، يحاول لفت انتباه الحاضرين في اجتماعات العائلة، لذا حاول تغطية خوفه تحت طبقات من البطش والتعذيب والتنكيل، مع رشّة من البساطة والمنطقية السطحية، حتى يكسب البسطاء من الناس.
تحبين باسل أكثر مني
رفض الروس إرسال الدعم، لكنه أبلغ من حوله أنّ الدعم في طريقه إلى دمشق، لأنه لو أبلغهم ذلك لهربوا وأحدثوا فوضى قد تمنعه من الهرب. نظر إلى الكرسي نظرة الوداع الأخيرة، هاجمته كل تلك الذكريات؛ لقاءاته بكل زعماء العالم وهم يتوسّمون خيراً به. “لماذا حصل كل هذا؟”: يخاطب نفسه ويشرد في صورة العائلة، ثم يوقظه رنين الهاتف، يستفيق: “عليّ أن أسرع… لا وقت للوقوف على الأطلال”. يتصبب عرقاً ويركض، ليداهمه خيال أمه: “ابق مكانك، قاتل حتى الرمق الأخير … لا تهرب كالنساء”. ينفجر في وجهها: “كنتِ تحبين باسل أكثر مني، لذا ابتعدي عن طريقي”. يأتي خيال الأب القائد يهدئ من روع زوجته ووريث الحكم يركض أمامها: “اتركيه يا أنيسة، لم يكن يوماً أهلاً لذلك”. يسمع بشار صوت أبيه وكلامه، يعود مسرعاً إلى الغرفة، يمسك بصورة العائلة، يطرحها أرضاً ويكسّرها بعنف وقهر وغلّ، ليهرع نحوه أحد الحراس: “سيدي الرئيس، سيدي الرئيس… السيارة تنتظر في الخارج”.
يندفع الرئيس إلى علبة المحارم، يمسح دموعه، يأخذ حبة “بنزوديازبين” المهدئة للقلق، يشرب من زجاجة الماء رشفتين، يأخذ بعض الأوراق على عجل، ويسرع نحو السيارة التي تقله نحو حميميم. ينظر من زجاج السيارة وهو يرى القطعات العسكرية يسودها الإحباط، ومحاولات الضباط والقيادات رفع معنويات الجنود المنهارة. كانت عبارة واحدة تطن في أذنه تجعله يبكي: “تبكي كالنساء على حكم لم تحافظ عليه كالرجال”، على وقع مشاهد لقاءاته في الأشهر الأخيرة والنصح الذي تلقاه من قيادات عربية وأجنبية، ينظر إلى الشوارع كئيبة خالية، ثم يتساءل في نفسه: “لا يوجد من يصفق لي ويهتف باسمي، لماذا؟ أين هم؟ أين ذهبوا؟”، لا جواب في الأفق، فقد خرج هذه المرة دون علم أحد، حتى السائق الشخصي كان يعتقد أنه ذاهب إلى ريف اللاذقية لتفقد المواقع العسكرية هناك، ثم أخبره أنه سيمر إلى حميميم في البداية، فأوصله مدخل المطار حيث كانت سيارة أخرى تنتظره. نزل الرئيس من السيارة الأولى وطلب من سائقه الانتظار بضع دقائق في انتظار الأوامر، وعندما صعد الرئيس في السيارة الثانية، نزل منها عنصر مسلح، أطلق النار على السائق المنتظر وذهب الاثنان إلى داخل المطار.
لحظة الحقيقة
أخبر الرئيس العنصر الثاني أنه سيأخذه معه إلى موسكو، فهو بحاجة إلى من يحميه هناك. تيبس العنصر في مكانه حين علم أنّ الرئيس يهرب الآن. تفجّر دماغه وهو يتذكر إخوته الثلاثة الذين “استُشهدوا” دفاعاً عن دمشق. بات لا يرى سوى دماءهم تسيل هدراً على الطريق، وخطر بباله أن يسحب مسدسه ويقتل الرئيس، ولكنه تمسك ببصيص الأمل في الهرب معه إلى روسيا، هناك قد يقدر على إعالة أمه المكلومة، بدل البقاء هنا فريسة سهلة للحكم القادم.
وقفت السيارة الثانية عند مدرج الطائرة التي ستقلع إلى موسكو، ترجّل الرئيس منها بعد أن أخبر السائق أن يلحق به بعد خمس دقائق. التفّ الرئيس من خلف السيارة، وأضحى وراء السائق، الذي كان يفتح قفل هاتفه ويبعث رسالة لأمه ليعرف كم حبة من الدواء بقيت في العلبة، ليحسب عدد الأيام المتبقية ليبدأ رحلة تأمينه من جديد، أرخى نفسه إلى الخلف قليلاً، نظر إلى مرآة السيارة الخارجية، فرأى الرئيس يحمل مسدساً، ثم لم يرَ شيئاً سوى السواد، وفي لحظة دخول الرصاصة إلى رأسه، عرف الحقيقة، وودّ لو كان يستطيع التراجع عن مسيرة حياته، وعلى الأقل كان يمني النفس أن يخبر الآخرين بما حدث، ودارت في تلك اللحظات الكثيفة تساؤلات: “لماذا تكون لحظة الإدراك هي ذاتها لحظة فوات الأوان؟”.
مسدس الطقم وكاتم “الكرافة”
عاد السواد والهدوء إلى بقايا وعي السائق المقتول، ثم سمع صوت أمه توصيه بعلبة الدواء كيلا ينساها كعادته، وبعدها ساد الصمت، بعد ثوان أصبح يرى مشهداً من الأعلى يشبه تصوير الدرون؛ الرئيس يضع مسدسه في الجيب الداخلي لطقمه الأنيق، ويفصل كاتم الصوت عن المسدس، ويخبئ الكاتم في جيب سري على الوجه الخلفي لكرافته الفاخرة، يصعد درج الطائرة مسرعاً، يسمع حديثاً باللغة الروسية بين عسكري على باب الطائرة والرئيس، يتعالى صوت النقاش ليصبح صراخاً غير مفهوم، ينتهي بتفتيش الرئيس وتسليم جميع قطع الأسلحة المخبأة في ثيابه.
يجلس الرئيس منهاراً في مقعد بجانب الشباك، يحاول لملمة ذاته ريثما يصل إلى موسكو للقاء أولاده وزوجته، يبدأ تأثير “البنزوديازبين” ويغلب عليه النعاس، وهو لا يرى سوى صورة أمه وهي تنهره وصوت أبيه حين كان ينصح ويجهز باسل للحكم متجاهلاً ابنه الطبيب المستقبلي، ثم ينام بفعل المهدئ.
العلاج النفسي مع الديكتاتور
يستيقظ بعد ساعات على وقع المطبات الهوائية، يصرخ بخادمه الشخصي فلا يجيبه. ينظر حوله: “إنها طائرة!”، يأخذ بضع ثوان ليتذكر ما حدث، يتمنى لو كان حلماً؛ “إنه حلم بكل تأكيد، فأنا سأبقى للأبد مثل والدي”. يحاول النوم مرة أخرى عله يستفيق ليكون ما حدث مجرد كابوس كالعادة، عله يستيقظ فيجد نفسه في سريره الأبيض الوثير، يتناول التاب ويشغل عليه مقاطع جمعها له مستشاروه لحشود تهتف: “بالروح بالدم…”، نصحه بها المعالج النفسي بعد معرفته أنّ العلاج النفسي غير ممكن مع الديكتاتور، وهذا ما توصل إليه الطبيب النفسي كذلك، التأكيد في كل مرة أنه على أتم الصحة الجسدية والنفسية، والمشكلة هي في الناس والمجتمع والعرب والغرب والعالم كله.
“تباً إنه ليس مناماً”: يصرخ بصمت، ثم تذكر كيف كان يأتي بخدمه حين كان صغيراً يطلب منهم أشياءً صعبة، مثل تغيير سياق مسلسل يحضره، أو إعادة تجميع كأسه المفضل الذي كُسر لقطع صغيرة، ومن بعد ذلك، يستذكر جلسات الاجتماع مع ضباطه ومستشاريه بعد كل هزيمة أو تراجع عسكري، مطالباً إياهم بالنصر أو أنه سيقيلهم أو يقتلهم: “جيبولي النصر من تحت الأرض، مهما كانت الخسائر والتكاليف”، وكان يتحقق ذلك في أغلب الحالات. كان يشعر أنه يمتلك العالم، وأنه قادر على تحقيق المستحيل، وحرف مسار الكرة الأرضية، يتمنى اليوم لو يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الخلف، ثم التصرف بشكل مختلف: “تُرى أين أخطأتُ؟ وما هي الخطوة الناقصة”، يتساءل في سره بضع ثوان، ثم يجاوب نفسه: “لم أخطئ في شيء، لربما كان يجب عليّ إبادتهم منذ البداية، ربما لما كنت وصلتُ لهذه الطائرة”. يفكر بضع ثوان: “ربما هي خطيئة والدي في الثمانينيات، فقد أبقى منهم من هجموا عليّ الآن، كان بإمكانه إبادتهم حينها، دون أن يدري أحد!” يصمت برهة ثم يضيف: “وهي خطيئة أمي أيضاً، لم تصر على والدي بما فيه الكفاية، ولم تنصحني بذلك، كانت تكتفي بالتهكم بي!”.
رصيف 22
————————————–
==========================




