سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 14 شباط 2025
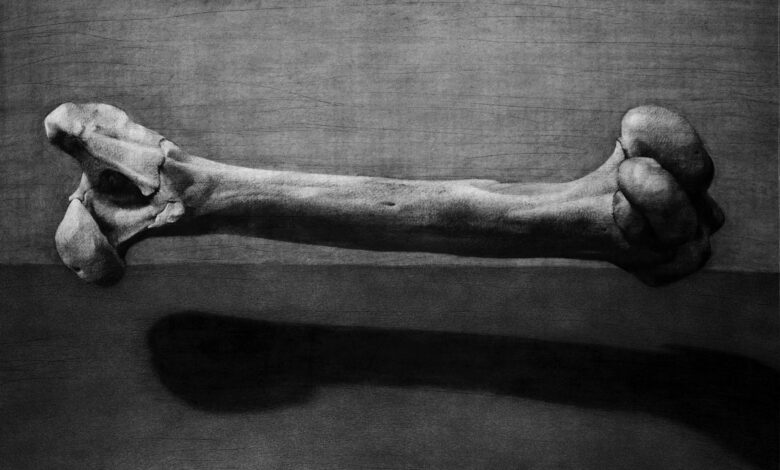
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————–
إرث «الحركة التصحيحية»: ما تبقى من جثة البعث الهامدة/ صبحي حديدي
تحديث 14 شباط 2025
بعد حلقة أولى، ابتدأت نقاش قرارات صدرت عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، وتناولت إرث «الحركة التصحيحية» من زاوية جيش النظام كما أعاد حافظ الأسد تركيبه في أعقاب انقلابه على رفاقه يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1907، وورّثه لابنه بشار، سنة 2000؛ وحلقة ثانية تناولت الأجهزة الأمنية المختلفة، تحت إدارة الأسد الأب والابن؛ هذه حلقة ثالثة تتناول حزب البعث العربي الاشتراكي، في ضوء قرار حلّه رسمياً كنقطة انطلاق. ولكن، أيضاً، باعتباره ظلّ جثة هامدة خلال 14 سنة من عمر الانتفاضة الشعبية، ومُسخ أو تحوّل عشرات الآلاف من أعضائه إلى مخبرين أو عناصر أجهزة قمع واستبداد ونهب وفساد أو مجندين في ميليشيات فاشية و/أو طائفية تخدم النظام وتنخرط في شبكات التهريب وجباية الأتاوات وإنتاج وتصدير الكبتاغون…
وليس مضحكاً فحسب، بل مدعاة تأمّل فريد في أقدار تمزج المهزلة بالمأساة ،أنّ الحزب استبق، بنحو 50 يوماً، قرار الحلّ الرسمي، فلم ينتظر أكثر من 4 أيام أعقبت انحلال نظام «الحركة التصحيحية» وفرار بشار الأسد حتى اتخذ قراراً ذاتياً بـ«تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية» فضلاً عن إجراءات أخرى تضمنت تسريح جميع الكوادر المتفرغة وإعادة الموظفين المعارين والمنتدبين، ووضع جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية، وتحويل العائدات إلى مصرف سوريا المركزي. وهذا، في نهاية المطاف، «جيش» من المرتزقة والانتهازيين الوصوليين والعملاء والفاسدين، يقدّر البعض أنّ أعداده وصلت إلى 900,000 ألف، والبعض يذهب إلى 1,200,000عضو أو نصير أو متفرغ.
هذا المآل هو الطرف المأساوي الظاهر من جبل جليد حزب سياسي بلغ من العمر 77 سنة ساعة تجميد أنشطته ذاتياً، وحكم في سوريا والعراق على مدى عقود، وانتشرت فروعه وأجنحته في مشارق الأرض العربية ومغاربها؛ إنْ لم يكن بسبب المزيج القوموي الميتافيزيقي وشبه/ الشوفيني شبه/ الفاشي الذي ابتدعه مؤسساه، ميشيل عفلق وصلاح البيطار، حين اختلطت أفكار ساطع الحصري مع مثالية فيخته وسوبرمان نيتشه؛ فعلى الأقلّ من باب الجاذبية، الطنانة الجوفاء والشعبوية الخادعة، لشعار «أمّة عربية واحدة/ ذات رسالة خالدة»؛ أو تلفيق غوغائي عالية التخدير، مثل «العربي سيّد القدر» حسب زكي الأرسوزي أحد الآباء المؤسسين للحزب.
طرف المهزلة، من جبل الجليد/ الجثة الهامدة إياها، تولاه الأسد الابن نفسه، بوصفه الأمين العام للحزب، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها كوادر الحزب في أيار (مايو) من العام ذاته الذي سجّل انطواء صفة الحزب، ونظام «الحركة التصحيحية». يومذاك، وبعد أن انتُخب أميناً عاماً، وعيّن 45 عضواً من أصل 125 أعضاء اللجنة المركزية الموسعة؛ انخرط الأسد في تنظير، سقيم كالعادة وأجوف لا يبلغ حتى سوية الترهات، فامتدح تطوير عمل الحزب بوصفه «حاجة حسية ووطنية وطبيعية» مستذكراً أنّ «سياسات الحكومة يجب أن تنبثق من رؤية الحزب، من دون أن يلغي أحدهما الآخر».
بعض المهزلة كان يتبدى أوّلاً في اجتماعات أقرب إلى كرنفالات الضحك على الذات، قبل خداع أبناء سوريا من جهة أولى؛ ولأنها أيضاً، من جهة ثانية، كانت تردد أصداء ارتطام تنظيرات الأسد بعضها ببعض، خصوصاً تلك التي توهمت، ذات يوم، البناء على خديعة 2012 بصدد حذف مادة في دستور أبيه تنصّ على أنّ حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع؛ ثم انقلبت على التوهم ذاته، حين سعت إلى إعادة تكريس سلطة الجثة الهامدة من خلال انتخابات حزبية داخلية، لم تلحظ حتى تكرار هذا أو ذاك من سيناريوهات التزييف المعتادة.
وليس بعيداً عن اختلاط المأساة بالمهزلة ذلك «التنظير» لوذعيّ اللغو والترهات بدوره، الذي خرج به الأسد الابن نفسه في خطاب مشهود أواخر العام 2011، حين كشف عن خطط لتجييش المواطنين المدنيين، ليس اعتماداً على ما اعتاد حزب البعث تصنيفه تحت مسمى «المنظمات الشعبية» أي اتحادات الطلاب والشبيبة والعمال والفلاحين ونقاباتها، فضلاً عن موظفي فروع وشُعَب الحزب في المناطق الأكثر التفافاً حول النظام، فحسب. بل كذلك ضمن تشكيلات مستحدثَة خصيصاً لهذه الغاية، فاشية في الشكل كما في المحتوى. ولن يعفّ النظام عن استخدام طرائق الفرز الدقيقة، الطائفية أو المناطقية أو العشائرية، التي أتاحت تشكيل تلك الوحدات المدنية، وعسكرتها وتسليحها وتدريبها، بحيث اهتدت بفلسفة معمار الفرقة الرابعة إياها، إذْ أنها في نهاية المطاف عملت فعلياً تحت إشراف ضباط تلك الفرقة، مباشرة أو بالإعارة والتكليف.
وكان الأسد الابن قد أطلق صفة «القفزة الكبيرة» على مؤتمر البعث القطري العاشر، أواسط 2005، فاتضح سريعاً أنه لم يكن قفزة بأيّ معنى، حتى إلى وراء! فالمؤتمر ذاك شدّد، في الشؤون الداخلية وحدها، على «تنظيم علاقة الحزب بالسلطة» ودوره في «رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع» و«تحديد احتياجات التنمية». وفي مسائل «تطوير النظام السياسي وتوسيع دائرة العملية السياسية» أوصى المندوبون بمراجعة أحكام الدستور «بما يتناسب مع التوجهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر»؛ وأكدوا «أهمية دعم أجهزة السلطة القضائية واستقلاليتها» و«تكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد، والحدّ من ظاهرة الهدر في المال العام». وهكذا: في القاعات كان الهذر والإطناب اللفظي والارتزاق والتجييش، وفي الشارع الشعبي كان البؤس والقهر والاستبداد والفساد.
وأمّا في الأصل، أي خلال عهد الأسد الأب والمؤتمر القطري السابع أواخر 1979، فقد كان رفعت الأسد، شقيق رأس النظام وقائد «سرايا الدفاع» وجزار سجن تدمر، هو الذي تولى (من موقع عضو القيادة القطرية للحزب) التبشير بالفاشية الأكثر وضوحاً في حينه: مَنْ ليس مع «الثورة» هو في صفوف أعدائها حكماً، والحاجة «الثورية» تقتضي شنّ حملة «تطهير وطني» ترسل المعارضين إلى معسكرات عمل وتثقيف في الصحراء. بذلك كان الأسد الشقيق يستبق حركة الاحتجاج الشعبي التي سوف تتبلور ضمن إطار الأحزاب المعارضة غير المنضوية في جبهة السلطة، وفي النقابات المهنية للأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة والمحامين، الذين أعلنوا إضراباً ليوم واحد (31/3/1980) احتجاجاً على غياب الحريات وشراسة آلة القمع وانتهاك حقوق المواطن. وكان ردّ السلطة الفوري هو حلّ هذه النقابات، واعتقال عدد من أبرز قياداتها؛ وبعد أشهر سوف تشنّ السلطة حملة واسعة ضدّ أحزاب المعارضة.
ولعلّ تاريخ هذه الجثة الهامدة لا يُستكمل، كما يليق به، إلا إذا ذًكر التعديل الجوهري الذي أدخله الأسد الأب على بنية الحزب المجتمعية، وربما الديمغرافية والمناطقية والإثنية والطائفية؛ تماماً كما سارع، فور نجاح انقلابه، إلى إعادة تركيب وحدات الجيش النظامي وإعادة تكوين الأجهزة الأمنية، موضوع الحلقتين السابقتين من هذه السلسلة. فقبل انقلاب الأسد الأب كان النهج التنظيمي في الحزب يحذر من التنسيب العشوائي للأعضاء، بمعزل عن دراسة ما عُرف آنذاك تحت مصطلح «المنبت الطبقي» بوصفه ضمانة نقاء الحزب طبقياً وضمان هيمنة «الكادحين» في صفوفه. ما فعله الأسد الأب فقد كان العكس تماماً، أي فتح أبوب التنسيب على مصراعيها، بل تعمُّد إشاعة «تمييع» طبقي يخدم تحويل فروع الحزب وشعبه إلى مخافر أمنية ومراكز وشاية واستخبار وكتابة تقارير.
وتلك، بين أنساق أخرى من الانحطاط، كانت حال جثة الحزب الهامدة؛ التي اتضح أنّ حلّها نفسها، مثل حلّها بيد الإدارة العسكرية، مجرد تحصيل حاصل اهتراءٍ وتفسخ وامّحاء.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
—————————-
شهوات أيديولوجية: هل يستحق المتغلّب عشقنا؟/ محمد سامي الكيال
تحديث 14 شباط 2025
يبدو أن المتغلّبين، أي من نالوا السيادة نتيجة عمل عنيف ما، مترافق مع نوع من السرد، الذي يحوي عناصر بطولية أو ملحميّة، وبغض النظر عن مستواه، ينالون شعبية لا بأس بها، وسط شرائح من الكتل السكانية في المنطقة، وليس فقط بين مَنْ يُسمّون «العوام»، بل أيضاً مَنْ يقدّمون أنفسهم بوصفهم صانعي ثقافة أو «محتوى»، ونخباً فكرية وأكاديمية. ليست هذه بالظاهرة الجديدة، ولا تقتصر على دول المنطقة، إذ يمكن القول إن الوله بالمتغلّب ظاهرة قُتلت بحثاً، وعلى كل المستويات، من الأدب وعلم النفس وحتى النظرية السياسية واللاهوت، وعلى اختلاف المجتمعات والثقافات وأنظمة الحكم. جَسَدُ صاحب السيادة قد يصبح تجسيداً لكثير من القيم والأفكار والترميزات والأخلاقيات، وبالتالي هو جَسَدٌ مرغوب، وقادرٌ على منح الملذات والآلام، على المستوى المادي والتخيّلي، والتي قد تكون مؤسِّسة لعوالم كاملة، مما نعتبره «الواقع» في عصر ما.
عندما نتكلم عن «رغبة بالمتغلّب»، فهذا لا يعني نوعاً من «الانحراف» النفسي الفردي، أو حتى الجماعي، فالرغبة، وفق هذا المنظور، لا تشير إلى ميل أو انجذاب ينحصر موطنه في الذات، بل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية، التي تخترق الأفراد والجماعات، في كل موضع وتفصيل في حياتهم. هي سابقة عليهم، وتساهم في صياغة ذواتهم. وهذا يعني أن رغباتنا قد تكوّن أصداءً للاقتصاد، السياسة، الأمم والشعوب، مختلف أنواع المرويات الشفوية والكتابية، والأدوار الاجتماعية والجندرية، أو هلوسة عنها. يصعب هنا التمييز بين «السوي» و»المنحرف» في الرغبة؛ أما تخيّل عالم، لا ينجذب فيه البشر إلى زعامات كارزمية، تمنح لرغباتهم وخيالاتهم وانفعالاتهم التجسّد، فقد يكون مجرّد وهم. كما يمكن النقاش حتى في مدى أخلاقيته، إذ كيف سيبدو عالم دون قادة ومعلمين وأنبياء؟ غالباً ستتعثر التجربة الحياتية والسياسية والأخلاقية، التي نسميها «النضج»، دون الجدل، أو حتى الصراع مع أولئك الآباء، وإذا غابوا فسيعيد البشر ابتكار بدائل عنهم، أو يقومون باستيهام وتخيّل تلك البدائل.
الجميع إذن معرّضون للوقوع في غرام متغلّب ما، وقد يبقون أوفياء له أو يتمرّدون عليه، إلا أن المتغلّب، لكي يكون صاحب سيادة فعلاً، يجب أن يكون مؤسِّساً لعالم ما، وليس فقط بالعنف، وإنما بنمط من الهيمنة الفكرية والأخلاقية؛ والأداء الاجتماعي والرمزي، الذي يتضمّن نوعاً من الجماليات؛ والقدرة على منح المعاني لكثير من الوقائع والممارسات، ومنها عنف السلطة نفسه؛ فضلاً عن ضمان تأدية الوظائف الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الحد الأدنى من الأمن والغذاء والصحة والتعليم، أي أن صاحب السيادة ليس محارباً أو مدمّراً فقط، بل هو قادرٌ على فرض نمط سلامه الخاص. فأي سلام يفرضه متغلبو منطقتنا؟
يصعب رصد أي «سلام» أصلاً، فهؤلاء المتغلبون ليسوا أكثر من قادة ميليشيات، أو زعماء دول فاشلة في أحسن الأحوال، يعاني رعاياهم من أسوأ الظروف، ويتعرّضون لكبت وحرمان مروّع، مع انسداد كامل للآفاق الحياتية والحيوية. فضلاً عن انحدار عام في المستوى الأخلاقي والجمالي على كل الصعد. ما الجذّاب في متغلّبين من هذا النوع؟ ولماذا ما نزال معرّضين للوقوع في غرام سلطاتنا، غير المنتجة، والفاشلة، ومنحدرة الذائقة؟
إباحية «الأزعر»
قد يمكن تفسير الميل للمتغلبين الحاليين بعقيدة أو أيديولوجيا ما: «الإسلام»، أو الإسلام السياسي، أو القومية. وربما، في بعض الأحيان، قد يُنسب إلى ظواهر، تعتبر سلبية أو متخلّفة، مثل الطائفية أو العشائرية. هكذا يكون المتغلّب تجسيداً لدين أو أيديولوجيا أو جماعة ما. إلا أن هذه العقائد والظواهر تتطلّب من أنصارها نوعاً من الانضباط، وتفرض عليهم، في الحالات الاعتيادية، كثيراً من الأطر الثقيلة، الدينية أو الأيديولوجية أو العرفيّة. بالطبع، يكمن الاستثناء في قلب الاعتيادي، إذ تبيح أشد العقائد والأعراف صرامة، فسحة لانطلاق أكثر الشهوات والانفعالات جموحاً، وبشكل شرعي وبطولي، كما في حالة استباحة أعداء الدين، أو الطائفة، أو الشعب، أو الأمة. عندما يتعلّق الأمر بعدالة مطلقة، أو «حل نهائي» لأزمة ما، أو تدمير عدو غاشم، أو «استئصال ورم من جسد الأمة»، فكل شيء مباح. ولذلك مورست كثير من الانتهاكات، ومجازر الإبادة الجماعية، باستمتاع خاص من قبل مرتكبيها، أو في لحظة غياب كامل للتعقّل، يتعذّر تفسيرها فيما بعد حتى بالنسبة لمن عايشوها. ويصعب تعداد المجازر في منطقتنا، التي ارتكبها، بمتعة عارمة، مسلّحون يحملون صورة زعيم ما. فداءً له، أو دفاعاً عن قضيته، أو انتقاماً من أعدائه.
تبدو حالة متغلبي المنطقة الحاليين تعميماً شاملاً لحالة «الاستثناء» تلك، ما يفقدها الصفة الاستثنائية. إذ لا انضباط مؤسِّساً لنظام، أو أمة، أو جماعة سياسية متماسكة، أو حتى تطبيقاً لشرائع دين، بل هو نوعٌ من الإباحية المستشرية، المرتبطة بمثال المتغلّب، الذي نجح، في أعين أنصاره، في تحقيق نصر ما، عبر نمط معيّن «البراغماتية»، والمفهوم الأخير يبدو كبيراً على ذلك النمط من التفكير، ربما الأصح القول نمط معيّن من «الشطارة»، المنفصلة عن أي قيمة، أو حتى مفهوم جدّي للمنفعة. يجعل هذا المتغلّب أقرب لـ»أزعر»، أو كبير الزعران، وليس قائداً، فهو قد سمح بإباحة انفعالات معيّنة، في الانتقام، أو قهر الأعداء، أو تحقيق الغلبة لحشد ما، دون أي إطار لمساءلته عن مشروعه وغاياته.
في الحالة السورية مثلاً، تتصاعد الأعمال الإجرامية، على خلفية الكراهية الدينية والإثنية والمناطقية، والتي تشمل ممارسات، مثل الهتاف الجماعي بالشتائم الطائفية، استباحة القرى، خطف النساء، الإعدام الجماعي. ويبدو من تصريحات ممثلي سلطات الأمر الواقع، وأنصارهم، بمن فيهم بعض «النخب»، أنهم يعتبرون هذه الظواهر «طبيعية»، و»أقلّ من المتوقع»، و»مؤقّتة»، ولذلك لا تستدعي تدخّلاً صارماً، أو حتى إدانة صريحة، وربما تصبح بديلاً عن أي سعي جدي لإقامة نظام سياسة وعدالة يستحق اسمه، على الأقل في المدى المنظور. أليس هذا تلميحاً غير مباشر، ولكن شديد الوضوح، بإباحة تلك الانتهاكات، والتطبيع معها؟
من جانب آخر، فإن «نشوة الانتصار»، بما يرافقها من تعبيرات إنشائية، ورموز بصرية، ومرويات، ليس ظالماً وصفها بالرديئة، تبدو أكثر أهمية من أي تفكير بالمشروع السياسي، أو الإطار الدستوري، أو الإجراءات الإدارية والتنظيمية، أو مصادر الشرعيّة، وكأن «النشوة» وحدها تنتج سلطة، أو تشرعن قائداً. يبدو كل هذا أقل من أيديولوجيا؛ وأدنى من تأسيس هوية جماعية ما، حتى لو كانت طائفية؛ وأشد رثاثة من أن يكون تعبيراً عن مصالح اجتماعية. إنها أقرب لحالة انفلات شامل في مجتمعات مدمّرة، باتت عاجزة عن أداء الوظائف والعمليات الأساسية للتحضّر. المتغلّب هنا قد يكون تجسيداً لتلك الهمجية، والوله به أقرب لهلوسة مجموعات، فقدت أي إطار متسق لإنتاج المعاني والقيم.
مهزلة الرغبة
قد يفيد مفهوم «دال الهيمنة»، في توضيح الفرق بين الزعامة الكارزميّة والتغلّب الأقرب للهمجيّة: المقصود بـ»الدال» هنا علامة تختزل قيم السيادة وأخلاقياتها، قادرة على التأثير الانفعالي بجمهور عريض، ما يسمح بإنشاء ائتلاف متعدد الفئات والمطالب، وتصليب وحدته. وهذا الدال قد يكون شخصاً، أو رمزاً، أو حتى عبارة. يرغب الأفراد في ذلك الدال، ويرتبطون به، إما بصفته مثلاً أعلى؛ أو صوتاً لجماعة؛ أو تجسيداً لمعانٍ مجرّدة؛ أو تمثيلاً متكاملاً لهوية؛ أو تعبيراً عن فئة خاصة، تكثّف في قضيتها مطالب الجميع؛ أو دلالة على القوة، التي افتقدتها مجموعة مضطهدة طويلاً. من الأمثلة الشهيرة على هذا زعامات تاريخية مثل نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ؛ وشعارات بسيطة وشديدة الدلالة مثل «الخبز والسلام»؛ وتصدير قضية النساء، في بعض الحركات الاجتماعية المعاصرة، بوصفها تكثيفاً لمسائل، مثل المساواة والتحرر ورفض الاستغلال والعنف ومناهضة التمييز. بالطبع، لا تعني تلك الدوال بالضرورة ممارسات سياسية مثالية، أو حتى صحّة وعدالة القضية التي تعبّر عنها، ولكنها طريقة لخلق رمز سيادي، يعبّر عن القوة المعنوية لحراك سياسي واجتماعي ما، وقادر على جمع الأنصار، والتأثير على وعيهم ولاوعيهم.
لا يبدو متغلبو منطقتنا دوالَّ على قيم أو أخلاقيات لائتلاف سياسي، بل علامة على الغياب التام للقيم والأخلاقيات، والذات السياسية نفسها. إلى درجة أن جمهورهم يبدي استعداداً كبيراً للتغاضي عما هو معروف من ممارساتهم وماضيهم وأقوالهم، التي قد تصل إلى درجة القتل الجماعي لأطفال، التطهير الطائفي والعرقي الممنهج، رفض مبدأ السيادة الشعبية، واعتبار الديمقراطية شركاً. وهذه القدرة على التغاضي توصف بـ»الواقعية». ما يدفع للتساؤل عن مفهوم «الواقع»، الذي ينفي أي قيمة سياسية أو أخلاقية فعلية، بل يتجاوز حتى ردود أفعال، قد تكون متوقعّة بشكل بديهي لدى التعاطي مع هذا النمط من الشخصيات، مثل الاشمئزاز من هيأتها وممارساتها، أو التعاطف مع ضحاياها. قد تكون هذه «الواقعية» هي دال الهيمنة هنا، أكثر من جسد المتغلّب نفسه، فهي علامة على التطبيع من الرثاثة السياسية والاجتماعية الشاملة؛ وغياب القدرة على طرح الأسئلة؛ والوحشية المنفلتة تجاه الآخرين؛ والانحدار العام في الذائقة والمخيّلة.
الجمهور القابل للوقوع في غرام هذا «الواقع»، بنخبه وعوامه، لا يمكن أن يكون ائتلافاً سياسياً، يدرك ذاته وهويته الجماعية، أو حتى تمهيداً له، بل أقرب لحشد، تحرّكه انفعالات شديدة البدائية والسلبيّة، دون أدنى قدرة على عقلنتها. ربما لذلك لا يمكننا أن نرصد حججاً جديّة بين أنصار المتغلّبين/الزعران، باستثناء تعبيرات ضعيفة المستوى عن مشاعر، مثل الإحساس بالظلم أو الفرح أو التفاؤل أو التشفّي؛ وجملاً إنشائية، لا تقول شيئاً فعلياً؛ ومقولات مكررة، تفتقر إلى الدقة أو المعنى، ولا يمكن تفحّص مصداقيتها. ما الذي يرغبه أنصار هذا «الواقع» فعلاً؟ ربما تكون الإجابة أنهم لا يرغبون شيئاً فعلياً، أو بالأصح عاجزون عن الرغبة. فالرغبة، بمعناها الأعمق، دافع وطاقة حيوية معقّدة، ترتبط بتركيبات اجتماعية وثقافية متعددة العناصر، وتحوي بالتأكيد رموزاً وخيالات وأفكار وعقائد، منتجة لوقائع وأطر جديدة. فيما يحتفي «واقعيو» المتغلّبين/الزعران بـ»إنجازات»، مثل مجازر «صغيرة»، أقل من المتوقع؛ تطرّف ديني لم يصل إلى درجة تطبيق حدوده في الشوارع؛ «شعب» لا يهتم بسياسة، أو نمط نظام الحكم الذي يخضع له، بل فقط يريد خبزاً وأماناً، ولن ينالهما غالباً، ما دام يسود في أوساطه الاعتقاد بأن السياسة وطبيعة النظام لا علاقة لهما بالخبز والأمان، أو مجرّد ترف.
قد تكون أول خطوة لاستعادة السياسة، في تلك المجتمعات المدمّرة، هي مواجهة ذلك المفهوم غير الواقعي لـ»الواقعية»، إذا لا يمكن تحقيق الحد الأدنى من الاستمرارية الحياتية، في ظل الخضوع لحشد، تطبّع حتى «نخبه» مع الهمجية، وتحتفي بفقر فكرها ومخيلتها، وعجزها عن الرغبة.
كاتب سوري
القدس العربي
——————————-
تنظيمات جهادية على التليغرام/ رشا عمران
14 فبراير 2025
يكاد لا يمر يوم منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول (2024) لا نسمع فيه خبرا في سورية عن عملية خطف أو قتل أو العثور علِى جثث لأشخاص أعلن عن اختفائهم قبل أيام. وغالبا لا تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي سوى الحوادث والانتهاكات التي تتعلق بالأقليات، ولا سيما العلويين، رغم أن باقي المحافظات تشهد الحالة نفسها من عمليات الخطف والقتل والسرقة والانتهاكات اليومية، ولأن أخبار تلك المحافظات لا تحقق المطلوب من الشحن الطائفي لا يتم تناقلها إلا ضمن نطاق ضيق؛ بينما هناك مئات من الصفحات الإلكترونية المخصّصة لنشر (وتناقل) أي خبر يمس الأقليات والعلويين على وجه الخصوص، حتى لو كانت أخبارا زائفة أو ملفقة، خصوصا مع ظهور قنوات على التليغرام تابعة لفصيل جهادي مشبوه ظهر فجأة ليتبنى كل عمليات القتل والخطف والانتهاكات التي تتم بحق العلويين.
سرايا أنصار السنة هو الفصيل الذي، كما يقال، يقوم بالارتكابات ضد العلويين، وبحسب بياناتٍ يصدرها، فهو يستهدف العلويين والشيعة فقط من دون تمييز، أي لا يعنيه إن كان هذا الشخص مرتكباً أو له يد في الدم السوري أم لا، ولا يعنيه تاريخه إن كان معارضا لنظام الأسد أم لا، مجرد كونه علويا أو شيعيا فهو عرضة للاستهداف الآن أو غداً. يتزعم هذا الفصيل شخص يدعى أبو عائشة الشامي، الذي قرر الانفصال عن هيئة تحرير الشام بعدما رفض تساهلها مع (الروافض والشيعة). والمعلومات المتناقلة عن الفصيل كلها مأخوذة عن الصحافي الفرنسي سيدريك لا بروس المتخصص في ديناميكية المجموعات المسلحة والمعارضة المدنية في سورية؛ بينما لم تصدر عن السلطة الجديدة أي كلمة بخصوص هذا الفصيل وما إذا كان فعلا ينتمي سابقا إلى الهيئة أم هو مجرد ادعاء لإضفاء المصداقية على وجوده وإبعاد الشبهات حول حقيقته، أو لتكذيب البيانات التحريضية التي تبثها قنواته على التليغرام.
سنكون واهمين إن ظننا أن هذا الفصيل لا يبث الخوف في نفوس علويي سورية، وهم الذين اعتادوا على سماع نظرية أن سقوط نظام الأسد سوف يتسبّب لهم بمذبحة أبدية. وسنكون أيضا واهمين إن اعتقدنا أن العلويين يثقون بالحكومة الجديدة، وهذا لا يعني أنهم يتمنون عودة النظام السابق، فهم اكتشفوا، أخيرا، أنهم لم يكونوا أكثر من وقود يحرقه كما ووقتما يشاء في حرب حفاظه على السلطة؛ لكن الأمر هو شعورهم بأنهم متروكون لمصير مجهول ويتم تناقل أخبار عن أنهم سوف يحرمون من وظائف الدولة ومن الانتساب لقوى الأمن وللجيش ومن التعليم في الجامعات. وهذه كلها أخبار تتناقل عن لسان مسؤولين في السلطة الجديدة دون أي إسناد حقيقي ولكن أيضا دون أي نفي لها من السلطة.
يشعر العلويون حاليا بأن الجميع يتخلون عنهم تماما، وهو ما يشجع كل المتربصين بسورية لاستثمار هذا التوجس والخوف لديهم ودفعهم نحو التقوقع أكثر أو نحو طلب الحماية من ألد أعداء سورية، ذلك أن فقدان الإحساس بالمواطنة يلغي قيمة الوطن، وقد اختبرنا هذا جيدا في سنوات الثورة الأولى، حين طالب الثوار بحماية دولية لمناطقهم تنجيهم من إجرام نظام الأسد، وكانوا محقين في طلبهم ذلك؛ ورغم أن علويي سورية حتى اللحظة لم يتعرضوا لجزء بسيط مما تعرّضت له بيئات الثورة (السنية)، ولكن لا يمكن التحكّم بالخوف وبنتائجه. هذا يعرفه جيدا من اخترعوا فصيل سرايا أنصار السنة، ومن يبثون بياناته المحرضة. وفي رأيي، هذا الفصيل مرتبط بدول إقليمية لا تريد لسورية أي استقرار، أو ربما يعنيها أن تتقسم سورية وتتشكل من مجموعة من الدويلات الطائفية التي يكثر الحديث عنها حاليا في الشارع السوري، البعيد عن دمشق وحلب وحمص وحماة.
الكرة الآن في ملعب السلطة الانتقالية لكشف من وراء هذا الفصيل المخرّب وفضحهم أمام الرأي العام، ولطمأنة الخائفين من السوريين، إن كانت سلطة لكل سورية، كما تقول عن نفسها، وإن كان السلم الأهلي أول أهدافها كما يفترض أن يكون.
العربي الجديد
——————-
بودكاست “عيون الكلام”: حوار سوري في أوروبا/ مصطفى الدباس
الجمعة 2025/02/14
يقدم بودكاست “عيون الكلام” منذ انطلاقته العام 2023، جهداً إعلامياً مثيراً للإعجاب بقدرته على إنتاج محتوى يعكس التراكم البحثي حول الشأن السوري المتسارع، فيما يقدم نفسه كمنصة حوارية تطرح القضايا السورية بعمق، مستهدفاً جمهوراً واسعاً داخل سوريا وخارجها، ضمن رؤية تجمع بين التحليل الإعلامي والاستناد إلى البحث والتوثيق.
البودكاست هو أحد منتجات شركة الإنتاج “Pioneers Innovation” التي أسسها سوريون ولبنانيون من ذوي الخبرة في العمل الإنساني، بهدف تقديم محتوى يخدم الشأن العام بأسلوب مستدام يوازن بين الجودة والاستقلالية المالية. وولدت فكرته أواخر العام 2022 كمقترح قدم لإنشاء منصة صوتية متخصصة في الشأن السوري، قبل أن تتبلور إلى مشروع متكامل يواصل اليوم موسمه الثاني، في محاولة لتقديم سردية إعلامية مختلفة، خارج حدود الرقابة الإعلامية والسياسية التقليدية بطريقة عصرية ومحتوى صوتي وبصري مميز ضمن فئة الإعلام المستقل، الذي يكسر قيود الخطاب الرسمي، ويتيح للسوريين فرصة للحوار بعيداً عن الإملاءات السياسية.
ويتناول البودكاست، الذي تقدّمه ألمى عنتابلي وهيا العلي، بالتعاون مع المنتج ومخرج الأفلام الوثائقية سليم سلامه في الإخراج، القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، خصوصاً القضايا التي تؤثر في السوريين في المنافي، كما يعود إلى لحظات مفصلية في تاريخ سوريا لفهم تأثيرها في الواقع الحالي واستضاف عدد من الكتاب والممثلين والباحثين والناشطين والصحافيين والاختصاصيين في مجالات مختلفة.
وحول الهدف من البودكاست، أوضح مدير المشروع عزام مصطفى: “هنالك فجوة بين الأبحاث الأكاديمية المتخصصة والجمهور العام، حيث تبقى العديد من الدراسات والمقالات التحليلية محصورة داخل الأوساط الأكاديمية، من دون أن تجد طريقها إلى شريحة أوسع من الناس”، وأضاف في حديث مع “المدن”: “يسعى عيون الكلام إلى سد الفجوة عبر تقديم القضايا المعقدة بأسلوب مبسط وحواري جذاب، يمزج بين التحليل العميق والسرد التفاعلي، لجعل المعرفة أكثر قرباً وسهولة للمستمعين”.
ولم يكتف “عيون الكلام” بمعالجة القضايا السياسية التقليدية، بل توسع ليشمل مواضيع كانت محرّمة أو مسكوتاً عنها في الإعلام الرسمي تحديداً، ومن أبرز القضايا التي ناقشها قبل سقوط النظام كانت العلاقة بين الدراما السورية والسلطة، وكيف تم توظيف الإنتاج الفني لتلميع صورة النظام وإعادة إنتاج خطابه السياسي وتأثير ماهر الأسد في الدراما، وهو ما تحدث عنه الممثل السوري فارس الحلو الذي كان ضيفاً في إحدى الحلقات. كما تناول البودكاست الاقتصاد السوري في مطلع الألفية، حيث استضاف الخبير جهاد يازجي للحديث عن التحولات التي أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى، وتأثير الفساد الاقتصادي في اندلاع الثورة السورية.
وهنا أكد مصطفى أن “عيون الكلام” لن يكون محصوراً في زاوية واحدة، بل يسعى إلى استكشاف سوريا من خلال رواية التاريخ وتحليل الواقع والغوص في الذاكرة الجمعية للسوريين، من أجل خلق مساحة جديدة للتفاعل والحوار، لأنه “من خلال الغوص في التفاصيل التي ساهمت في صناعة التاريخ السوري، يمكن للمستمع أن يعيد قراءة التاريخ بشكل مختلف تماماً عن الرواية التي كان النظام السوري يصدرها للسوريين والعالم ككل”.
إلى ذلك، يسلط البودكاست الضوء على قضايا الأقليات، مثل الأكراد والإسماعيليين، والتي ظلت مغيبة عن الخطاب الرسمي، بل وتم تهميشها حتى في بعض المنصات الإعلامية المعارضة، ما يمنح البودكاست دوراً مهماً في إعادة صياغة الوعي العام. علماً أنه مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لم يتغير المشهد الإعلامي السوري جذرياً، بل بقيت وسائل الإعلام الرسمية شبه متوقفة عن العمل، بانتظار تفعيلها بشكل جديد تصبح فيه مساحة حقيقية للحوار العام بدلاً من كونها بوقاً للسلطة كما كان الحال طوال 54 عاماً.
وهنا، يستمر “عيون الكلام” في تقديم محتوى تحليلي متعمق، مع التركيز على القضايا الأكثر إلحاحاً في المرحلة الجديدة، مثل السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، إضافة إلى العلاقة بين السوريين والفضاء العام، حيث تناول في حلقة بعنوان “من الإقصاء إلى المشاركة” كيفية استعادة السوريين لدورهم في صناعة القرار بعد عقود من الاستبداد السياسي، وفي حلقة أخرى، استضاف مجموعة من الصحافيين المستقلين لمناقشة تحديات الإعلام السوري في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب الدعم الحقيقي للإعلام الحر.
من الناحية التقنية، يتمتع “عيون الكلام” بمستوى إنتاجي احترافي يميزه عن غيره من المنصات الإعلامية المستقلة، من حيث جودة الصوت العالية والمونتاج المتقن ما يعزز من تجربة الاستماع. كما أن تسجيل الحلقات بصيغة مرئية يمنح البودكاست حضوراً أقوى في منصات مثل “يوتيوب”، ما يتيح تفاعلاً أوسع مع الجمهور. واستغل فريق العمل أيضاً منصات مثل “انستغرام” لبث مقاطع ترويجية للحلقات بصرياً، كما أن نشر حلقات “عيون الكلام” في “سبوتيفاي” و”آبل بودكاست” و”غوغل بودكاست” جعله متاحاً لمختلف فئات المستمعين، سواء داخل سوريا أو في الشتات، ما زاد من تأثيره كمصدر إعلامي مستقل.
وحول التحديات المرتبطة بإنتاج البودكاست بتمويل داخلي محدود، قال مخرجه سليم سلامه: “الاعتماد على كوادر بسيطة خلال التصوير والتسجيل لعب دوراً كبيراً في خفض الكلفة، خصوصاً أننا قمنا بتمويل المشروع ذاتياً”. وأضاف في حديث مع “المدن”: “بعد بحث طويل، وجدنا استوديوهات في فرنسا وألمانيا وهولندا بأسعار مناسبة مقابل جودة عالية، ما سمح لنا بالحفاظ على مستوى احترافي في الإنتاج”.
وعن أبرز التحديات خلال الموسم الأول، أوضح سلامه أن التنقل بين بلدان أوروبية مختلفة بسبب تباعد أماكن إقامة الضيوف، تسبب في تأخير النشر وزاد من الضغوط خلال الإنتاج. لهذا السبب، قرر الفريق تصوير الموسم الثاني بالكامل في فرنسا، إلى جانب الاعتماد على مقابلات أونلاين مع بعض الضيوف.
أما التحدي الأكبر في الموسم الثاني، فكان مواكبة التحولات المتسارعة في سوريا، حيث بدأ التصوير قبل سقوط النظام بأيام، ما فرض تغييرات جذرية في محتوى الحلقات لتواكب الواقع الجديد بحسب سلامه الذي وأوضح أن الفريق يعمل حالياً على إيجاد طرق للتواصل مع الجمهور وشرح أن بعض الحلقات تم تسجيلها قبل هذه التحولات، وهي مهمة تتطلب جهداً إضافياً لضمان وضوح السياق.
ورغم نجاح “عيون الكلام” في تقديم محتوى مستقل، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة ترتبط بطبيعته كمنتج إعلامي يُنتج خارج سوريا. يتم إعداد البودكاست في أوروبا، ويستضيف غالبية ضيوفه من السوريين المقيمين هناك، ما يثير تساؤلات حول غياب أصوات السوريين في الداخل، ومدى إمكانية إنتاج حلقات من داخل سوريا مستقبلاً، لتسليط الضوء بشكل مباشر على واقع من يعيشون هناك.
في المقابل، يمنح إنتاج البودكاست خارج سوريا، حرية أكبر في اختيار المواضيع والضيوف، بعيداً من الرقابة المباشرة لأي سلطة ناشئة في سوريا مستقبلاً، وهي ميزة ربما لا تتوافر للعديد من المنصات الإعلامية داخل البلاد. وفي المقابل، يواجه “عيون الكلام” تحديات لوجستية تؤثر في انتشاره، أبرزها محدودية الموارد التي حالت دون إمكانية التنقل إلى مدن مثل إسطنبول أو الدوحة أو القاهرة، حيث مجتمعات سورية كبيرة ومتنوعة خصوصاً من بين الشخصيات المؤثرة سياسياً وثقافياً. وأكد مصطفى أن الوصول إلى هذه المجتمعات كان سيمنح الحلقات بُعداً أوسع من خلال تسليط الضوء على تجارب مختلفة للسوريين في أماكن متفرقة، مضيفاً أن توسيع آليات الإنتاج مستقبلاً قد يساعد في تجاوز هذه التحديات وتحقيق انتشار أوسع.
أما في ما يتعلق بإمكانية تقديم محتوى من داخل سوريا، فإن البيئة الإعلامية هناك ما زالت غير منفتحة على التعددية الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول شكل الحلقات، وهوية الضيوف، ومدى قدرة عيون الكلام على تمثيل قضايا السوريين في الداخل. وهنا، شدد عزام على التزام البودكاست بالاستقلالية: “نحن كسوريين انتزعنا حريتنا من نظام مستبد حكم البلاد لعقود، ولن ننتظر من أي سلطة جديدة أن تملي علينا ما يجب أن نتحدث عنه أو من يمكننا استضافته”. وأضاف: “سنواصل استضافة كل الأصوات التي تمثل القضايا المطروحة، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية”.
إلى جانب ذلك، تبقى الاستدامة المالية تحدياً رئيسياً، فمعظم الإعلام المستقل يواجه صعوبة في تأمين دعم خارج دائرة النفوذ السياسي، وعلق مصطفى: “يواجه البودكاست، مثل غيره من المشاريع المستقلة، مشكلة الاستدامة المالية. التمويل ذاتي حتى الآن، من خلال شركة الإنتاج Pioneers Innovation”. وأضاف: “صناعة البودكاست عربياً ليست مربحة، وسورياً الوضع أصعب بكثير. حتى الآن، التسجيل يتم وفق القدرة والاستطاعة، من دون خطط ثابتة طويلة الأمد”.
من جهتها، تحدثت الإعلامية ألمى عنتابلي، التي عملت في مؤسسات إخبارية كبرى مثل “يورو نيوز” و”العربية”، عن تجربتها الجديدة في إعداد وتقديم البودكاست بوصفها “مختلفة تماماً عن كل ما قدمته في مسيرتي الإعلامية الممتدة على مدى 19 عاماً”.
وأوضحت عنتابلي في حديث مع “المدن” أن تعاملها مع الشأن السوري كان جديداً عليها، حيث اعتادت في المؤسسات الإخبارية العربية على تناول الملف السوري كجزء من تغطية عامة وسريعة للأحداث الدولية، بينما جعلها البودكاست تتعامل مع الحدث السوري بتركيز لأن “الحوار أكثر عمقاً وهدوءاً، مستنداً إلى أسئلتنا وهمومنا كسوريين، بعيداً من ضغط الأخبار العاجلة والقيود الزمنية للإعلام التقليدي”.
وحول تأثير سقوط النظام على محتوى الحلقات، قالت عنتابلي: ” أنتجنا خمس حلقات بعد سقوط النظام، حملت أسلوباً مختلفاً عن المعتاد، حيث ابتعدنا قليلاً عن محتوى الـGreen Content، أي الحلقات القابلة للاستماع في أي وقت، واتجهنا أكثر نحو مواكبة اللحظة السياسية”، وأضافت: “اليوم، هناك نقاش حول مستقبل البرنامج، وكيف يمكن أن يتطوّر شكله بعد هذا التغيير”.
المدن
———————————-
سلّة تين السياسة/ ممدوح عزام
14 فبراير 2025
في كلِّ يومٍ، منذ شهرين تقريباً، أي منذ إسقاط النظام السوري، يصل إلى حسابي على فيسبوك بضع دعوات إلى الانضمام إلى أحد التيّارات السورية الناشئة التي تتشكّل في البلاد أو خارجها. وإذا كان في هذه الدعوات من أمرٍ مُشرق، فهو أنَّ السوريّين الذين خرجوا من عهد الظلام المُغلَق، باشروا فوراً محاولاتهم لتشكيل الحوامل التنظيمية لهمومهم السياسية والاجتماعية، من جهة، وكسروا ذلك الخوف من تشكيل الأحزاب أو الكتل والتيارات، الذي كان يؤدّي بهم، أو بنا جميعاً بالطبع، إلى الاعتقال، من جهة ثانية. هكذا تبدو سورية اليوم ورشات عملٍ ضخمة تتسابق جميعها لإعلان أنها هي التي ستحمل أمانة بناء العهد الجديد.
لِمَ هذا كلّه؟ ربّما هي شهوة السوري لإثبات الوجود، فقد كان السوريون مغيّبين ومُراقبين. أقصوا عن المشاركة في تنظيم وتقرير مصائرهم الشخصية والمصائر الجمعية معاً. وفيما بدا في الزمن السابق حالة من الحذر من الآخر، القريب والبعيد، بحيث بدت حالة “الاستياء” التي يشير إليها الروائي الهندي بانكاج ميشرا في كتابه “زمن الغضب” (صدر عن عالم المعرفة) حيث يوضع كل فرد في مواجهة مع الأفراد الآخرين، شديدة الخصوصية بالنسبة إلى السوري، إذ إنّها تنجم عن ضغوط السلطة الغاشمة على جميع أفراد الشعب، بحيث تولد حالة الغضب التي قد تثير نزاعات عنيفة يعتدي فيها أفراد أقوياء قليلاً على آخرين لأسباب غاية في البساطة.
في الجزء الأهم من هذا التحرّك السريع، توجد تلك الجمرة التي اعتقدنا أنّها ترمّدت وتلاشت من نفوسنا، بينما كانت في الحقيقة تُخفي شرارة الإيمان بالمستقبل، وهذا هو المتغيّر الجديد العظيم الذي أحدثه سقوط النظام القديم، وبزوغ نظام جديد آخر، يقدم وعوداً مختلفة تماماً.
لهذا تبدو هذه الحماسة لتشكيل التيارات والأحزاب نوعاً من التعويض عن الحرمان، تتجاوز الرغبة في تكوين الصوت القوي الذي يعبّر عن الجماعات.
ثمّة من يمزح بأننا نشبه المَثل: “حزين وقع في سلة تين”، بما يشبه هجوماً على السياسة، وبخاصّة تلك السياسة التي كانت ممنوعة أو محظورة، إلا في نطاق الطاعة.
من الواضح أن الوضع الجديد، الذي يبدي فيه السوريون هذه الرغبة في خلق الجماعات السياسية أولاً، ثم المدنية والنقابية، يُحدث صراعاً بين مفعول حالة الاستياء التي لا تزال حاضرة، ومفاعيل الرغبات في التخلّص من آثار الماضي في ظلّ انفتاح الأمل بالمستقبل. وهذا قد يفسر سرّ الانقسامات التي لا تتوقّف في الساحة السياسية السورية، فكلُّ سوريٍّ يريد أن يخرج من العباءة ليقول: أنا هنا. وهذا حقٌّ مشروعٌ وإنسانيٌّ ومطابقٌّ للحرية التي أردناها.
غير أنَّ الجوهري في فكرة بناء التيارات والأحزاب الجديدة هو المدى الذي يؤمن فيه أولئك الأفراد الذين يقررون بناء التنظيم المشترك بالديمقراطية في الممارسة السياسية داخل الحزب أو التيار أو الحركة أو التجمّع، بقدر ادعائهم الإيمان بها في المجال العام أو في المجتمع. بينما قد يضع النشاط السياسي الفردي فكرة العمل السياسي في خانة الاستياء القديمة والنزاع مع الآخر، بحيث قد يخشى المرء أن نخرج جميعاً أخيراً من السلّسة بلا ذلك التين الذي اشتهيناه.
العربي الجديد
———————————
من الجولاني إلى الشرع.. تحوّلاتٌ كثيرة وقائدٌ واحد/ ليلى الرفاعي و أحمد أبازيد
تنقّل أحمد الشرع، الذي صعد اسمه عقب قيادته معركة إسقاط الأسد، بين تنظيماتٍ جهاديةٍ وتحوّلاتٍ فكريةٍ وجدت لها مساحة جغرافية تطبيقية في الشمال السوري.
2025-01-16
من الجولاني إلى الشرع.. تحوّلاتٌ كثيرة وقائدٌ واحد
ما بين الجولاني والشرع سيرةٌ بدأت من الجولان وانتهت في قصر الشعب | تصميم خاص بمجلة الفِراتْس
مجلة الفراتس · من الجولاني إلى الشرع.. تحوّلاتٌ كثيرة وقائدٌ واحد
أمامَ أريكةٍ خشبيّةٍ موشّاةٍ بالصَّدَف العتيق في قصر الشعب بدمشق، وقف قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ببدلةٍ رسميةٍ فضفاضةٍ – ربّما لتخفي تحتها مسدّساً أو سترةً واقية – مصافحاً رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري بعد حديثهما عن ضرورة التعاون لمنع عودة نشاط خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وحماية السجون التي زُجّ بها مقاتلو التنظيم في الأراضي السورية. حديثٌ بانت فيه لكنةُ الشرع الدمشقيّةُ بلا ريب. قد يبدو مشهداً عادياً في بلدٍ شبّ عن طوق آل الأسد أخيراً على يدِ شابٍّ جامحِ الطموح تتهافت الوفود العربية والغربية إلى القصر لرؤيته، ويتخبّط بعض روّاد فندق الشيراتون قربَ ساحة الأمويين في دمشق، يذمّونه ورجالَه سرّاً ويتماوتون أمام أعضاء هيئته في سبيل رؤيته، علّهم ينالون سبقاً بصورةٍ ينفردون بها على وسائل التواصل الاجتماعي – أو للتاريخ – أو بتصريحٍ جديد.
لكنّ اجتماع هذين الشتيتَيْن ليس مشهداً عاديّاً بل فتحاً يشتهيه الشعراء، إذ قلّما يجود الزمان بفرصةٍ لتقف منتصراً بعدَ معركةٍ تاريخية أمامَ خصمٍ خَدَعْتَه، أو خَدَعْتَ أسلافَه الإداريين يومَ اعتقلوك في مطلع الألفية. يومها جلس شابٌّ سوريٌّ عشرينيٌّ زحف من دمشق ليجاهد في العراق، حاملاً هويّةً عراقيةً مزيّفةً أمام المحققين الأمريكان والعراقيين، وخاطبهم بلهجةٍ لا شائبة فيها حتى ظنّوه عراقيّاً فسجنوه خمسةَ أعوام. ثمّ دار الزمن دورته وأتى العراقيّون ليصافحوا ذلك الشابَّ على أرضه وفي القصر الرئاسي ويطلبوا منه مساعدتهم في القضاء على حليفِه الأقدمِ تنظيم الدولة، في رحلةٍ ضاربة الجذور والفصول خاضها رجلٌ، غُيِّرت أسماؤه وألقابه وصفاته مراراً، وغُيِّر معها تنظيمه وهيئته والآن حكومته.
أحمد الشرع، بأحدث أسمائه، أو قائد الإدارة السورية الجديدة بآخِر أوصافه، سليلُ آل الشرع من وجهاء الجولان السوريّ، وبها تكنّى بِاسمِه الجهاديِّ ذائعِ الصيت: الفاتح أبو محمد الجولاني. يتطابق اسمُه مع أحدِ أعلام آل الشرع الذين قادوا ثورة الزويّة السورية “المنسيّة” على الفرنسيين، وربّما يُشابِه سَمِيَّه كذلك في أنّه “المتَّكَأ لآل الشرع، والمُحدِّث اللبق” كما وصفه حسين، والد أحمد الشرع، في كتابه “ثورة الزويّة السورية المنسية 1920 – 1927″، الصادر سنةَ 2022.
أحمد، الذي قاد معركةً أسقطت في أيّامٍ معدودةٍ وعلى نحوٍ مفاجئٍ بشار الأسد وأنهت تسلّط عائلته نحو ستّة عقودٍ على رقاب السوريين، بدا لغير المتبصّرين بالشأن السوريّ شخصاً مجهولاً، أو ربما داهيةً ينتمي إلى تنظيمٍ جهاديٍّ مسلّحٍ يهدّد بإغراق المنطقة في دوامةٍ جديدةٍ من التشدّد والعنف. لكن ما يحمله أحمد الشرع من إرثٍ عائليٍّ، وما تحمله سيرته من تحوّلاتٍ في الخطاب والأفكار والعمل، يَشِيان بصورةٍ أعمق. فمِن عائلةٍ ذات جذورٍ سوريّةٍ أصيلةٍ، وعُمرٍ قضاه متنقّلاً بين التنظيمات المسلّحة، وعينيه المسلّطتين على حُكم آل الأسد، وصولاً إلى إطاحته ببشار وإنهاء حُكمه، تتكشّف ملامح صورةٍ شديدة التعقيد لمَن سَمَّى نفسَه أخيراً أحمد الشرع.
يبرز لنا كتاب “ثورة الزويّة السورية المنسية 1920 – 1927″، الذي كتبه الدكتور حسين الشرع والدُ أحمد الشرع، وثيقةً نادرةً عن تاريخ العائلة ومسقط رأسها. يحدّثنا حسين، الاقتصاديّ المختصّ بالنفط، أن عائلة الشرع بالأصل من قرية جيبين التابعة لمدينة فيق عاصمة منطقة الزويّة، جنوبَ محافظة القنيطرة في الجولان السوريّ المحتلّ. وهُم من العوائل الأصيلة في المنطقة، ويدّعون أنهم من سلالةٍ تتّصل بآل البيت. ويمتلكون نحوَ 85 بالمئة من أراضي مدينة فيق، وزيتوناً في وادي مسعود على تخوم المدينة، ولهم فيها بيوتٌ تسمّى “بيوت الشرع”، طال أذى الفرنسيين سكّانَها نكايةً بآل الشرع الثائرين الذين ارتحلوا إلى الأردن عقبَ قتلِهم مديرَ ناحية المنطقة في عشرينيات القرن الماضي، وكلَّ القوى الجديدة التي جاءت لإدارة المنطقة تحت راية الفرنسيين. وقد كان آل الشرع من أصحاب الحلّ والعَقد في المنطقة حتى سُمّيت قرية جبين سابقاً “عاصمة القرار” لأهميّتهم فيها.
بعدَ أيّامٍ قليلةٍ من سقوط نظام الأسد كان وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بمسمّاه الرسميّ وزعيمُ الطائفة الدرزية في لبنان بمسمّاه الأهمّ غير الرسميّ، من أوائل الشخصيّات التي التقاها أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق. تطرّق الشرع في لقائه إلى الحديث عن أسلافه، وتحديداً طالب الشرع وقاسم الشرع أصدقاء سلطان باشا الأطرش القائد العامّ للثورة السورية الكبرى سنة 1925 وأحد رؤوس الطائفة الدرزية. وتحدّث الشرع عن دورهما في مواجهة الفرنسيين وفي “ثورة الزويّة المنسية التي لم يعرفها التاريخ”، كما وصفها والده. انتهز الشرع الفرصةَ ليطرح تناصّاً تاريخياً بين الثورة المنسيّة على الفرنسيين والثورة السورية على نظام الأسد، مشيداً بدور أهل السويداء من الدروز الذين شاركوا بالثورة و”ساعدوا بتحرير منطقتهم وعملوا تحت إدارة العمليات العسكرية”، التي تزعّمها الشرع نفسه.
بسط حسين علي الشرع، والدُ أحمد، ذو التوجّه العروبيّ الناصريّ الحديثَ عن سيرته الذاتية في مؤلّفاته، ومنها نتعرّف على العوامل التي شكّلت أحمد الشرع نفسه في طفولته وصباه، إذ قضى أباه حياته كولده، جوّالاً بين مدنٍ عربيةٍ عدّةٍ يتلمّس طريقه ويحصد خبرةً غذَّت طموحه السياسي.
في كتابه “قراءة في القيامة الثورية” الصادر عن دار نقش للطباعة بإدلب – مقرّ نفوذ ولده وقت صدور الكتاب – سنة 2022، يتوقّف حسين الشرع عند انقلاب الثامن من آذار 1963 الذي أنهى أيّ نفوذٍ لمؤيّدي الوحدة بين سوريا والعراق ومصر، بعد انفصامِ عُراها قبل ذلك بعامين. عقب الانقلاب بشهرٍ، اندلعت بمسقط رأس حسين الشرع في فيق مظاهراتٌ طالَبَت بالوحدة مرّةً أُخرى، واحتجَّت على استئثار ضبّاط البعث بالسلطة. أجّج الطّلابُ ومنهم حسين الشرع هذا الحَراك، الذي جابهه الجيشُ يومئذٍ بالرصّاص. اعتُقل حسين ولمّا يبلغ تسعة عشر عاماً بعد احتجاجه على خطبة مدير المدرسة، وهرب لاحقاً من السجن وذهب إلى الأردن، حيث سُجن مرّةً أُخرى وخُيّر بين الذهابِ إلى السعودية أو العراق، فاختار العراق. هناك استقرَّ في بغداد وأكمل دراسة الثانوية فيها ثم التحق بالجامعة ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية مع التخصّص في النفط، وتخرّج سنة 1969. وفي أثناء دراسته، مُنِيَ العربُ بالهزيمة التي راجت تسميتها بالنكسة في الخامس من يونيو سنةَ 1967، فرجع إلى الأردن وعمل مع الفدائيين الفلسطينيين زمناً قبل أن يعود لإنهاء دراسته.
في سنةِ 1971 عاد والدُ الجولاني إلى سوريا، وسُجن مرّةً ثالثة. آنذاك خرج من سجنه بتسويةٍ مع شعبة الأمن السياسيّ بالمخابرات، وعمل مدرّساً للغة الإنجليزية في درعا. كان والد الشرع أيضاً ذا طموحٍ سياسيٍّ، إذ ترشّح لمجلس النُوّاب لكنّه لم يفُز. وترشّح لعضوية مجلس محافظة القنيطرة ونجح سنة 1972. وعُرف عن حسين الشرع وَلَعُه في تأليف الكتب. فقد انبرى حينَها لتأليف عددٍ من الدراسات عن قطاع النفط في سوريا. فكتب عن النفط العربي كتابين، أوّلُهما “البترول العربي بين الإمبريالية والتنمية (الامتيازات التقليدية)” الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 1973، والثاني “البترول والمال العربي في معركة التحرير والتنمية” الصادر عن الدار ذاتها سنة 1974. وأهمّ ما كتب كانت أطروحته “تخطيط الصناعات البتروكيميائية في سوريا” سنةَ 1975.
مكث والد أحمد الشرع في السعودية منذ سنة 1979 حتى سنة 1988 حيث وُلِد ابنُه أحمد سنة 1982. عمل حسين في وزارة النفط (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) باحثاً اقتصادياً عشر سنوات تقريباً وأصبح مديراً للشؤون الاقتصادية ومستشاراً في الوزارة. آنذاك كتب ستّة كتبٍ عن النفط والاقتصاد السعوديّ نُشرت ما بين دمشق والرياض. وكان له عشرات المقالات السياسية والاقتصادية المنشورة في صحيفتَي الرياض والجزيرة.
وفي سنة 1989 عاد والدُ الشرع مع أسرته إلى دمشق، وعمل مستشاراً لرئاسة مجلس الوزراء، ومديراً للعمليات في مكتب تسويق النفط التابع لرئيس المجلس وقتئذ محمود الزعبي. واستناداً إلى بعض المقابلات التي أجراها الباحثان حمزة المصطفى وحسام جزماتي وضمّناها تقريراً صحفياً نشرته “ميدل إيست آي” في يونيو 2021، انتهى المطاف بحسين الشرع ضحيّةً للظلم الإداريّ بعد رفضِه توقيعَ تحويلاتٍ اقتصاديةٍ غير قانونيةٍ طلبها مسؤولون في النظام السوري.
في دمشق حطّت عائلة حسين الشرع رحالَها جوارَ مسجد الشافعي في حيّ المَزّة، أحد الأحياء الراقية في العاصمة بمنطقة الفيلّات الشرقية. هناك عمل أحمد الشرع أثناء مراهقته في متجرٍ افتتحه والده للبقالة في دمشق بعد إنهاء عمله الحكومي، كما يَذكر في مقابلةٍ مطوّلةٍ أَجرَتها معه مجلة فرونتلاين ونُشرت في فبراير 2021. على أن هذه البيئة المكانية الأوسع التي نشأ بها الشرع، في حيّ المَزّة “غير المحافظ” – كما يصفُه في المقابلة – لم تدفعه نحو التيار الإسلامي. دفعته الانتفاضة الفلسطينية الثانية وهو في التاسعة عشرة من العمر ليفكّر “كيف يحقق واجب الدفاع عن الأمّة المضطهدة من المحتلّين والغزاة”، إلى أن نصحه أحدهم بالذهاب إلى المسجد والصلاة هناك، حيث وجد “معنىً آخَر مختلفاً عن المعنى الدنيويّ” دفعه للبحث عن الحقيقة التي وجدها بالقرآن، إذ درس تفسيرَه على يد شيخٍ فاضلٍ، فضّل عدمَ ذِكر اسمِه.
آنذاك كان حسين الشرع من الناشطين السياسيين المدنيين المطالِبين بالتغيير الديمقراطي. فقد كان حاضراً في المحاضرة الافتتاحية لمنتدى الحوار الوطني في الثالث عشر من سبتمبر سنة 2000، في أثناء ما يُسمّى “ربيع دمشق”، وهو اسمٌ أُطلق على الشهور الأولى لبشار الأسد في السلطة، لِما شهدت سوريا من انفتاحٍ سياسيٍّ وفكريٍّ واجتماعيٍّ امتدَّ نحو سنة. ثمَّ كان من وجهاء المجتمع المدني الذين وقّعوا على “إعلان دمشق” سنة 2005، وهو إعلانٌ يدعو إلى إنهاء ما يزيد على ثلاثة عقودٍ من حكم آل الأسد والانتقال إلى نظامٍ ديموقراطيّ. ومنذ سنة 2020 عاد حسين إلى التأليف بغزارةٍ مرّةً أُخرى. لم تتوقف كتاباته هذه المرّة عند الاقتصاد والنفط، بل امتدّت لموضوعاتٍ أُخرى اقتصاديةٍ وأدبيةٍ واجتماعيةٍ، صدر أغلبها عن دار نقش للطباعة والنشر، مثل كتابه “القيامة السورية (في كيفية إعادة إعمار سوريا)” المنشور سنة 2022، وكتابه “الأحزاب السياسية في البلاد العربية” المنشور سنة 2023، عدا كتاب “ثورة الزويّة السورية المنسية” المذكور آنفاً.
على التباين الفكريّ بين الأب والابن، أَقَرَّ أحمد في مقابلةٍ صحفيةٍ مبكرةٍ مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث سنة 2021 أن تأثير والده عليه كبيرٌ، شخصياً وفكرياً في آن. إذ يقول إنَّ “القومية العربية تدفع الإنسان ليقاتل لحقوق المضطهَدين، وذاتُ طبيعةٍ ثورية”. وأشار في المقابلة ذاتها إلى دور جَدّه الثوريّ ضدّ الفرنسيين، وإن كان “تركيزهما على الأمم العربية، بينما نوسّع نحن، كحركةٍ إسلاميةٍ، تركيزنا على كلّ الأمّة المسلمة”، إذ تختلف الأفكار بينما تتلاقى التأثيرات، كما في “الرغبة بالدفاع عن فلسطين والفلسطينيين المزروع في بيتنا طيلة الوقت” حسب قوله.
في أوائل سنوات الألفية، توالَت أحداثُ الانتفاضة الثانية ثم هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما أعقبها من “حرب أمريكية على الإرهاب” بلغت ذروتها بغزو العراق، لتضرب آلاف الشباب في صميمهم، فاختار بعضُهم التظاهراتِ الواسعةَ بينما بحث آخَرون عن مساراتٍ أخشن. كان أحمد الشرع من الشقّ الثاني، فتوجّه إلى بغداد قبل أسبوعين أو ثلاثةٍ من بدء حرب العراق، ثمّ ذهب إلى الرمادي، ومنها رجع إلى بغداد التي كان فيها حين اشتعلت الحرب. ثمّ عاد إلى سوريا زمناً قبل أن يرجع في رحلته الثانية الحاسمة بعد أعوامٍ قليلةٍ إلى الموصل ويقضي معظم وقته هناك، كما يفصّل شخصياً في مقابلته مع مارتن سميث لفرونتلاين.
وعدا تأكيده الشخصي في المقابلات الصحفية التي أجريت معه، تتضارب روايات الباحثين والكتّاب المتابعين لمرحلة العراق الغامضة، وأثرها في حياة الشرع. لكن تعاضد الروايات يخبرنا أنَّ رحلة الجولاني الثانية إلى العراق كانت صوب الموصل سنةَ 2005 تقريباً. ولم يُعرف كيف صار عضواً في “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين” ولا الدور الذي لعبه الجولاني آنذاك في التنظيم، وما إذا كان التحاقُه بالقاعدة قد سبق على تلك الرحلة الثانية. لكن عند تلك النقطة صار الجولاني جزءاً من “مجلس شورى المجاهدين” المنبثق عن تنظيم القاعدة في العراق، والذي ضمّ غالبيّةَ فصائل المقاومة السُنّية حينَها. تقول محلّلة الاستخبارات المركزية الأمريكية ندى باكوس في الفيلم الوثائقي “الجهادي” الذي أخرجه مارتن سميث سنةَ 2021، إن الجولاني كان يترأس خليّةً فاعلةً هناك تحت إمرة أبو مصعب الزرقاوي، أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي سينبثق عنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي حافظ الشرع على عضويّته به. ومع ذلك، ينفي الشرع تماماً في مقابلته مع سميث أنه قد التقى الزرقاوي لتَباعُد الأماكن بينهما، ناهيك عن “البروتوكول الأمنيّ المشدّد” الذي أحاط به الزرقاوي نفسه والذي حال دون إتمام اللقاء.
على أيّ حالٍ، ومهما كان دور أحمد الشرع حينها، فقد قبضت القوّات الأمريكية سنةَ 2005 تقريباً على شابٍّ يحمل هويةً عراقيةً ويتحدث بلهجةٍ عراقيةٍ أقنعت المحقّقين وعملاءهم المحلّيين بأنّه عراقيّ. يقول باحثون مختصّون بشؤون الجماعات الإسلامية، منهم تشارلز ليستر في كتابه “الجهادية السورية” المنشور سنة 2015، إنه كان يُعرف بِاسم أوس الموصلي، ويقول الباحث الأردني المختص في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية في تصريحٍ صحفيٍ نشره موقع درج في ديسمبر 2024 إنه عُرف باسم عدنان علي الحاج. ولكن في النهاية، لم يكن هذا الشخص سوى أحمد الشرع نفسه، مؤكِّداً أن قلّةً قليلةً فعلاً كانت تعرف أنه سوريٌّ عند اعتقاله أولاً في سجن أبو غريب، ثم معسكر بوكا، وهو معتقلٌ مخصّصٌ لسجناء الحرب العراقيين أنشأه البريطانيون سنةَ 2003 ثم سجن كروبر في مطار بغداد. بعد ذلك سلّمته القوّات الأمريكية إلى العراقيين الذين وضعوه في سجن التاجي حتى إطلاق سراحه بعد خمسة أعوامٍ من الترحّل بين السجون.
كان في سجن بوكا نحو عشرة آلاف معتقلٍ، منهم تسعةٌ من قادة القاعدة في العراق ومؤسّسي تنظيم الدولة لاحقاً. يقول أحمد الشرع في مقابلته مع فرونتلاين سنة 2021 إن دوره في السجن كان “إيصال الإيديولوجيا الصحيحة لمن حوله، فقد أدرك أن العديد حوله يحملون أفكاراً مغلوطةً حول الإسلام والدفاع والجهاد”، بلا صِدامٍ ولا خلافٍ وبمنهجيةٍ مختلفةٍ عن الآخَرين “الذين كان الكثير منهم ضبّاط شرطةٍ سابقين [يشير إلى الجذور البعثية العراقية لداعش] وحاول بعضهم جعل السجن إمارةً إسلاميةً حصل بها العديد من التجاوزات التي رفضتُها، ودفعت الكثيرين للانتقال إلى مهجعي من مهاجع أولئك القياديين”، كما يقول.
كان من بين هؤلاء قياديٌّ مهمٌّ تأثر بمواقف الجولاني في السجن. خرج قبله بأربعة شهورٍ وتولّى تنظيم “الولاية الشمالية للدولة الإسلامية في العراق”، أي نينوى غالباً وتشمل الموصلَ وما حولها، وتحدّث مع زعيم التنظيم حينها أبو بكر البغدادي عنه. لذا عند خروجه، كان البغدادي أوّلَ شخصٍ التقاه الشرع وأخبره عن نيّته العملَ في سوريا، إذ كان من القلّة القليلة التي تعلم أن الشرع من سوريا ولم يكن عراقياً. قبل توجّهه هناك، استفاد الجولاني من تجربة العراق والسجن، وبين عامَيْ 2010 و2011 كتب وثيقةً من خمسين صفحةً بعنوان “جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد”، سرد بها تاريخ سوريا وجغرافيّتها وتنوّعها الطائفيّ وكيفية وصول عائلة الأسد إلى السلطة والفروق بين العراق وسوريا من حيث الأحزاب والإخوان والطائفية وغيرها، والعمل على تجنّب الأخطاء التي حصلت في العراق. إلّا أن نسختها ضاعت في دمشق.
أرسل الجولاني تلك الوثيقة مع والي الشمال إلى أبي بكر البغدادي، وطلبَ لقاءه للحديث عن ضرورة الذهاب إلى سوريا. يقول الجولاني، في لقائه مع مارتن سميث، إنه فوجئ بتهلهل كفاءة البغدادي التحليلية في قراءة الموقف، وبشخصيّته الضعيفة، وببُعده عن المشهد. ويزعم الشرع أن البغدادي – عقب خروجه من بوكا – قضى أعواماً في سوريا بعيداً عن المشهد العراقيّ، قبل أن يرجع حين التَقَيَا، ولذا لم يكن حتى معروفاً بين قياديّي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.
وافق البغدادي فوراً، ومن هناك طلب الجولاني مئةَ مقاتلٍ لكن لم يرافقه إلّا ستّة مقاتلين، وطلبَ دعماً مادّياً فأعطاه البغدادي نحو خمسين إلى ستين ألف دولارٍ شهرياً لما يقارب سبعة أشهر، أنفقها في شراء عشرات البنادق، لم يستخدم معظمها بعد أن دُفنَت وصَدأَت، في رحلة عودة الشرع من العراق إلى سوريا أواخر 2011. رحلةٌ سيتغيّر معها الجولاني والبغدادي ويتغيّر انتماؤهما، وستُغيّر معهما الشرقَ الأوسطَ بأكمله موصلةً الشرع، بعد ثلاثة عشر عاماً حافلةً بالأحداث، إلى القصر الجمهوري السوري.
يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بعد سقوط نظام الأسد، ومحاطاً بعناصر الأمن العامّ ومشايخ المسجد وطلّابه، دخل أحمد الشرع مسجدَ الشافعيّ في المَزّة – الحيِّ الذي نشأ فيه – مبتسماً حبوراً تلاحقه كاميرات الشبّان المذهولة من هذا الشابّ السوريّ الذي يبدو مثل أيّ سوريٍّ عائدٍ إلى حيّه وبيته. غير أنّه عاد منتصراً بعد أن قاد معركةً حقّقت أضخم إنجازٍ حلم به السوريّون طيلة 54 عاماً من حُكم عائلة الأسد، وهو إسقاط هذه العائلة.
متربّعاً في حارته ومسجده بين جيرانه وشيوخه، شرح الجولانيّ أهمّية المعركة، معركة تحرير سوريا من الأسد بأدواتٍ محلّيةٍ وداخليةٍ من غير دعمٍ خارجيٍّ. معركة لَم تُعِدْه إلى بيته فحسب، وإنما حالت دون تفكيك العربِ السنّةِ في سوريا، كما أشار إليهم في تلميحٍ واضحٍ إلى طائفية النظام السابق.
ما بيْن خطابِ الجولاني الأوّل المسجّل صوتيّاً من غير وجهٍ أو اسمٍ صريحٍ، الصادر عن “مؤسسة المنارة البيضاء” في الرابع والعشرين من يناير سنة 2012، وبيْن جلستِه شاهراً اسمَ أحمد الشرع متربّعاً على الأرض في مسجد طفولته وبين جيران حارته في الحادي عشر من ديسمبر سنةَ 2024، مرّ الرجل الذي يتصدّر واجهة سوريا وأخبارها الآن بتحوّلاتٍ وصراعاتٍ كثيرةٍ لم تقتصر رحلته فيها على دوائر الحرب والانتقال بين تنظيماتٍ عدّةٍ فقط، ولكنها كانت رحلة تجريبٍ وتعلُّمٍ طويلٍ. من أميرٍ في الظلّ داخل تنظيمٍ سلفيٍّ جهاديٍّ في بلدٍ مجاورٍ، إلى قائدٍ سياسيٍّ في العلن لا يُخفي طموحَه برئاسة سوريا القادمة.
يمكن رصد رحلة صعود الجولاني بدءاً من نهاية 2011 حين تأسيس تنظيم “جبهة النصرة لأهل الشام”، بعد أن قدّم مشروع الجبهة إيّاه إلى زعيم “دولة العراق الإسلامية” أبي بكر البغدادي، الذي كما أسلفنا وافق على رعاية المشروع وتمويله، وإضفاء الشرعية عليه بين الجهاديين السلفيين.
في سوريا أسّس الجولانيّ تنظيمَه مبتدياً بدائرةٍ ضيّقةٍ من الستّة الذين أتوا معه من العراق، مضيفاً إليهم الرفاقَ الذين عرفهم سابقاً وآخَرين انتقاهم وبايَعوه في سوريا، وهؤلاء أسّسوا مجموعاتٍ حولهم في شمال سوريا وجنوبها وشرقها عبر دائرة الثقة والانتقاء نفسها. وفي الرابع والعشرين من يناير سنةَ 2012، أعلن الجولاني عن التنظيم في خطابٍ نموذجيٍّ في انتمائه إلى السلفية الجهادية العالمية، تلقّفته المنتديات الجهادية ووسائل الإعلام، وزَخَرَ بمفردات الجهاد والشريعة والكفّار. هاجم الجولاني في خطابه العلمانيةَ وما أسماه “مشاريع الدول” بشأن سوريا، وخصّ بالذكر دولاً بينها تركيا، وحذّر من الانخداع بها. وقتئذٍ لم يعرف أحدٌ أن صاحب الصوت هو أحمد حسين الشرع، ابنُ حيِّ المَزّة في دمشق. وكلّ ما عرفه الناس أنه يلقِّب نفسَه “الفاتح” و”الجولاني”. ولعلّ الجولاني عرف وقتها أنه يريد فتح دمشق بالذات، وليس روما أو كابل شأنَ الأدبيّات الجهادية.
حينئذٍ اختار معظمُ ناشطي الثورة السورية وسياسيّيها تكذيبَ هذا البيان واتّخاذَه صنيعةَ مخابرات الأسد، لنفي وجود جهاديين أو إرهابيين في صفوف الثورة السورية. واستمرّ هذا النفي وسردية المؤامرة واتهام النظام بالمسؤولية عن عمليات الجبهة اللاحقة للبيان، وخاصّةً التفجيرات الانتحارية التي راح مدنيّون بين ضحاياها كما في تفجير ساحة سعد الله الجابري بحلب في الثالث من أكتوبر عام 2012، وعملياتٍ أخرى قُتل فيها مدنيّون كثرٌ وتبنّتها الجبهة رسمياً، إلى أن اقتنع الجميع بأن الجبهة حقيقةٌ قائمةٌ وذهبوا باتجاه نفي صفة الإرهاب عنها حين صنّفتها الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب في الحادي عشر من ديسمبر 2012. وكان احتجاجهم مَرَدُّه إلى عدم تصنيف النظام في القائمة نفسها، أكثر ممّا هو حماسة للجبهة.
يرصد الباحث حمزة المصطفى في دراسته “جبهة النصرة لأهل الشام من التأسيس إلى الانقسام” الصادرة في نوفمبر 2013 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تجنّب الجولانيّ في تلك المرحلة تقديمَ جبهة النُصرة مشروعاً للحكم في سوريا، مخالفاً في ذلك الحركات الجهادية الشبيهة التي ظهرت في العراق ومالي، مكتفياً بترويجها جبهةً معنيّةً بالدفاع عن “أهل الشام”. استخدم الجولاني في ذلك خطاباً استقطب به آلافَ السلفيّين الجهاديّين العرب والسوريين الذين يبحثون عن خطابٍ وتنظيمٍ أكثر صلابةً، مقارنةً بالشكل الشعبيّ وغير المؤدلَج أو البعيد عن الصلابة التنظيمية الذي وَسَمَ مجموعات الجيش الحُرّ. ولكن حتى في هذه المرحلة كان الجولاني يشعر بأهمّية عدم استعداء المجتمع أو ترهيبه، فقلّصت الجبهةُ عمليّاتِها الانتحاريةَ، وأكّدت في بعض البيانات أنها تحرّت خلوّ المدنيين قبل تنفيذها. ولكن استمرّ اتهام الجبهة بالمسؤولية عن عملياتٍ مثل تفجير مسجد الإيمان في مارس 2013 الذي قُتل فيه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وهو من مشايخ سوريا المشهورين خارجها وداخلها وصاحب المواقف العلنية المؤيدة لنظام بشار الأسد، إلا أن الجبهة نفت مسؤوليتها بسبب عدد المدنيين الكبير بين الضحايا.
كان الجولاني يرى نفسَه صاحبَ مشروعٍ كبيرٍ، وكان يتنقل داخل مناطق سيطرة النظام، ويعقد اجتماعاتٍ سرّيةً، مع قادة فصائل جهاديةٍ أخرى يسألُهم مبايَعتَه. وقتئذٍ كان نمط عمليات الجبهة أشبهَ بتدخلٍ جراحيٍّ مقصودٍ تجاه أهدافٍ محدّدةٍ، بينما كان النشاط العسكري في الثورة السورية في معظمه من عمل مجموعات الجيش الحرّ المحلّية، والتي يعود إليها الفضل بسيطرة الثوّار على مساحاتٍ واسعةٍ من سوريا في سنة 2012 وبدايات 2013.
كانت هذه المجموعات أكثر انتشاراً ومغامرةً، ولو كلّفها ذلك خسائرَ بشريّةً واستنزافاً عسكرياً طويلاً. وحتى في السنوات اللاحقة من تطوّر جبهة النصرة، ظَلَّ الجولاني مقتنعاً بعدم دخول حروب استنزافٍ أو تكليف نفسه بأعمال “الرباط”، أي حراسة جبهات التماسّ الطويلة التي تستلزم عدداً كبيراً من المقاتلين، أو الانتشار على مسافاتٍ واسعةٍ لحفظ حدود السيطرة، ونَدَرَ أن اختارت الجبهة البقاءَ في مناطق محاصَرة. ركّز الجولاني مذ ذاك على بناء قوّات نخبةٍ هجوميةٍ مضمونةِ الولاء والفاعلية قادرةٍ على التدخّل لتغيير واقع السيطرة على الأرض.
في أبريل 2013 دخل الجولاني في صراعه الأكبر حين قرّرت دولة العراق الإسلامية التوسّعَ استغلالاً لانهيار الدولة المركزية في سوريا وتمدّد النقمة الطائفية في العراق. علم البغدادي أن الجولاني أخذ مالَ العراق وبنى تنظيمَه وحدَه في الشام، فأعلن البغدادي دولته في العراق والشام وحَلَّ جبهة النصرة، ولكن الجولاني رفض ذلك وأعلن البيعة لتنظيم القاعدة الذي أقرّ الجولانيَّ أميراً لفرعه في الشام. غادَرَ حينها كثيرٌ من الجهاديين العرب والأجانب جبهةَ النصرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي عُرفت اختصاراً بِاسم “داعش”، بينما احتمى الجولاني بمظلّة تنظيم القاعدة في مواجهة تنظيم الدولة، وأصبح تابعاً رسمياً للظواهري بعدما كان محسوباً عليه بتأويل خطابه وسلوكه.
استفاد الجولاني من داعش في صورة التمويل والدعم الأوّلي من البغدادي، ثمّ انقلب عليها، وخسر مجموعاتٍ جهاديةً كثيرةً انفصلت عنه بعد أن استفاد منها أيضاً. ومن أبريل 2013 حتى يوليو 2014 تقريباً، اختار الجولانيُّ الكُمونَ وتعميقَ صِلاتِه بالفصائل السورية لتدعيم الولاءات محلّياً، مع تأكيد شرعيّته الجهادية المستمَدّة من تنظيم القاعدة والترويجَ لنفسِه بديلاً أكثرَ “اعتدالاً” في نظر الجهاديين الرافضين لداعش، مكثّفاً نشاطَه العسكريَّ ضدّ نظام الأسدِ فقط، دون طرح نفسِه مشروعَ حكمٍ أو منافسةٍ للفصائل الأخرى. أفرزت تحرّكاته حمايةَ تنظيمه في إدلب مستفيداً من تدخّل جبهة أحرار الشام لحمايته من تكرار انقضاض مقاتلي الدولة الإسلامية على مقارّ جبهة النصرة في الرقة وحلب، والتي آلَت إلى القضاء على وجود جبهة النصرة في المنطقتين، كما يرصد حمزة المصطفى في دراسته.
لاحقاً، التزم الجولاني الحيادَ حين قرّر الجيش الحُرُّ شَنَّ حربٍ واسعةٍ على تنظيم داعش في بداية 2014، واختار عدمَ التورّط في الحرب الدموية الطويلة في دير الزور التي خاضها فرع جبهة النصرة هناك بقيادة ميسر الجبوري (أبو مارية القحطاني) مع الفصائل الأخرى، من دون وصول مؤازراتٍ من الجولاني. وعلى عتابِ أتباع جبهته في الشرق لتخلّيه عنهم، كان الجولانيّ يدرك أنه لا يريد أن يستنزف تنظيمه ولو كلّفه ذلك موارد النفط التي كان يجنيها من المنطقة الشرقية.
بعد فترة الكُمون هذه واسترداد عافية الجبهة على مستوى المال والكوادر وإبعاد تهديد داعش، بدأ الجولاني بتقديم نفسه مشروعاً للحكم بثوبٍ جهاديٍّ سلفيٍّ. فانتشرت في 11 يوليو 2014 خطبةٌ نُسِبَت له، حملت تأكيد نيّة الجبهة إقامةَ “إمارة إسلامية” وتطبيقَ الشريعة الإسلامية عبر محاكم شرعية. عقب تسرّب الخطبة صدر بيانٌ عن الجبهة في اليوم التالي نفى إعلانَ إمارةٍ إسلاميةٍ، لكنّه أكّد السعيَ لإقامتها وإقامة محاكم شرعيةٍ. وبدأ الجولاني على الفور سلسلة معارك ضدّ فصائل الجيش الحُرّ وحتى الفصائل الإسلامية الأقرب فكرياً له، ومنها جبهة أحرار الشام التي انقلب عليها بعد أن سبق لها الدفاع عنه ودعمه في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، وذلك في معرض “حملة ردع المفسدين” التي أعلنتها جبهة النصرة في 21 يوليو 2014، وبدأها الجولاني بمعركةٍ ضدّ “جبهة ثوار سوريا” مستهدفاً إنشاء مناطق خاضعةٍ لحكم جبهة النصرة، والخلاص من المنافسين بالتدريج.
بدأ الجولاني تموضعَه المحلّي في جبل الزاوية في ريف إدلب بالقضاء على جبهة ثوّار سوريا التابعة للجيش السوري الحُرّ بقيادة جمال معروف. وخلال عامَيْ 2014 و2016 قضى تباعاً على فصائل أخرى من الجيش الحُرّ في ريف حلب وإدلب وحماة، بينما خاضت فروع الجبهة في درعا والغوطة الشرقية وريف حمص حروباً أمنيّةً حافلةً بالصدامات والاعتقالات والاغتيالات. كثّف التنظيم نشاطه القضائيّ عبر دور القضاء الشرعي، ولكن مركز التنظيم الأهمّ بقي في الشمال السوري، حيث يقيم الجولاني نفسه.
بعد وضع نواة سلطته الأولى في إدلب، أراد الجولاني الانتقال خطوةً أخرى نحو المحلّية ومشروعه الخاصّ غير التابع لتنظيمٍ أكبر، واستغلّ غيابَ الظواهري الطويلَ وعدمَ رَدِّه على الرسائل في سنة 2016، فأعلن فكَّ الارتباط عن تنظيم القاعدة وتأسيسَ “جبهة فتح الشام” في الثامن والعشرين من يوليو 2016، وظهر أوّلَ مرّةٍ بصورته ووجهه في إعلانها بعد تخفّيه الطويل.
بالطبع لم يكن هذا التحوّل مُرضياً للظواهري الذي شعر بالغدر عند عودته للتواصل مع جنوده وأتباعه، كما قال في رسالته “فلنقاتلهم بنياناً مرصوصاً” المنشورة في نوفمبر 2017. أدّى هذا التحوّل إلى انفصال القسم الموالي لتنظيم القاعدة عن الجولاني وتأسيسهم تنظيم حرّاس الدين في الثامن والعشرين من فبراير 2018، والذي ضمّ الشرعيّ العامّ السابق سامي العريدي والقائد العام السابق قسام الأردني وقائد فرع النصرة في الجنوب أبو جليبيب الأردني، وغيرهم.
بعد هذا الإعلان بأشهرٍ وتحت قصف الطيران الروسي خسر الثوّارُ الأحياءَ الشرقيةَ من مدينة حلب في نهاية 2016. لم يلبث الجولاني أن قام بتحوّلٍ آخَر نحو تثبيت المحلّية والاعتدال، فأعلن تأسيس “هيئة تحرير الشام” في الثامن والعشرين من يناير 2017 التي كانت عند تأسيسها اندماجاً بين عدّة فصائل، منها “جبهة فتح الشام”، ولم يكن الجولاني قائدَها الرسميَّ، ولكن بقي تنظيمه الكيان الحقيقي فيها. وأدرك الجولاني أن التنظيم الصلب هو الأهمّ، وهو ما يمكنه الهيمنة على أيّ تحالفٍ أوسع، ولو لم يكن قائدَه الرسميّ.
لم تلبث أن تفكّكت الفصائل التي انضمّت إلى الهيئة تباعاً، وحارَبَها الجولاني حتى قضى على معظمها، بالتزامن مع الحملات الإيرانية الروسية التي تسبّبت حتى نهاية 2018 بخسارة الثوّار كلَّ جيوبِهم خارج الشمال السوري، وهو ما زاد من جاذبية إدلب وريف حلب مركزاً للحكم بالنسبة للجولاني.
خاضت الجبهة صراعاتٍ ضدّ فصائل الثوّار في كلّ هذه الجيوب سابقاً في إطار صراعات السيطرة. تسبّبت هذه الصراعات في زيادة الهشاشة الدفاعية التي عجّلت سقوطَ فصائل الثوّار غير الجهاديين المعارضين للأسد. فقد سبق الاقتتالُ الداخليُّ سقوطَ الحيِّ الشرقيِّ في حلب في ديسمبر 2016 وسقوطَ الغوطة الشرقية في مارس 2018 وسقوطَ ريف إدلب الجنوبي وريفَ حماة الشمالي في الحملة الروسية 2019 – 2020، حيث شاركت الجبهة (ثمّ الهيئة) في الهجوم على تجمّع ألوية “فاستقم كما أُمرْت” – وهو فصيلٌ في الجيش الحُرّ في مدينة حلب – وسهّلت دخولَ داعش إلى مخيّم اليرموك في أبريل 2015 ما قالت ورقةٌ صادرةٌ عن معهد كارنيغي في الشهر نفسه أنه تحرّكٌ أفاد نظامَ الأسد لمَيلِ تنظيم الدولة الإسلامية لتجنّب محاربته. لاحقاً قالت مصادر بالجبهة لصحيفة الشرق الأوسط في تقريرٍ نُشر في أبريل 2016 أن الانسحاب كان تدعيماً لجبهة الشمال، ثمّ سحبت جبهة الجولاني قوّتها الرئيسة من الجنوب في نهاية 2015 عندما رأت أن المعركة ضد “الجبهة الجنوبية” ستكون محسومةً لصالح الأخيرة.
كان الصراع الرئيس للجولاني مع المنافس العسكري والشرعي الأكبر في إدلب، حركة أحرار الشام، التي خاضت تحوّلاتٍ حرجةً وخجولةً ومتردّدةً لحسم تموضعها إما مع قوى الثورة والجيش الحرّ أو مع القوى الجهادية. وحين حسمت الحركة في يوليو 2017 قرارها ورفعت علم الثورة وأعلنت تحالفها مع فصائل الجيش الحرّ في مشروع إدارة المناطق المحرّرة، شعر الجولاني بتهديد مشروعه فهاجم الحركة التي انهارت أمامه، حتى سيطر على معبر باب الهوى في الثالث والعشرين من يوليو 2017، موطّداً بذلك بداية حكمه في إدلب حيث أسّس بعدها حكومة الإنقاذ في الثاني من نوفمبر 2017.
استمرّت الصراعات بين الجولاني والفصائل الأخرى طويلاً خلال الأعوام ما بين 2017 و2019، وأعادت الفصائلُ مرّةً بعد مرّةٍ تشكيلَ نفسها في تحالفاتٍ جديدةٍ وخوض صراعات ضدّ الجولاني الذي عَدَّتْ مشروعَه غيرَ ثوريٍّ، بل معادياً للثورة وعَلَمِها وأهدافها. كما ظهر في بياناتٍ عديدةٍ للمجلس الإسلامي السوري وناشطين ثوريين، وفي هتافات المظاهرات ضدّ هيئة تحرير الشام في ريفي حلب وإدلب منذ عام 2017 حتى ما قبل معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر 2024، وبادَرَ هو في أحيانٍ كثيرةٍ لهذه الصدامات لحسم سيطرته واستئصال المنافسين واغتنام أسلحتهم.
سنةَ 2018 خاضت “هيئة تحرير الشام” معاركها الأخيرة مع بقية الفصائل. أوّلاً مع “جبهة تحرير سوريا” التي جمعت حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي، ثمّ معركتها الأخيرة ضد “الجبهة الوطنية للتحرير” التي جمعت الفصائل الثورية في إدلب. ودارت رحى المعارك شهوراً بين الهيئة وحركة الزنكي في ريف حلب الغربي، فكانت أكثرَ المعارك حصداً للأرواح من الجانبين. وتمكّن الجولاني عند حسم هذه المعركة في يناير 2019 من بسط سيطرته على إدلب، وتأكيد مرجعية حكومته “حكومة الإنقاذ” في حكم هذه المناطق.
إلّا أن حكم الجولاني لم يستقرّ طويلاً قبل أن تبدأ الحملة الروسية الإيرانية على إدلب وأرياف حلب وحماة، والتي خسرت فيها الفصائل نحو نصف مساحة سيطرتها، حتى جرى تثبيت خطوط وقف إطلاق النار باتفاق سوتشي بين الرئيسين أردوغان وبوتين في مارس 2020.
عقب اتفاق سوتشي، بدأ وعي أحمد الشرع بفكرة بناء الدولة، متّخذاً من إدلب نموذجاً مصغّراً أو معمل اختبارٍ لتطوير مهارات الحكم لديه. هذا التحوّل الذي يمكن أن نسميه “الطَوْر الحَوْكَمِيّ” تشبه فيه هيئةُ تحرير الشام بقيادة الجولاني منظمةَ التحرير الفلسطينية في سعيها إلى إقامة الدولة الفلسطينية، كما شرحه يزيد صايغ في كتابه “الكفاح المسلّح والبحث عن الدولة” المنشورِ سنة 1997. تصرّفت الهيئة حينها بمنطق بناء دولةٍ مصغّرةٍ في إدلب، ونموذجٍ لحكم الدولة في سوريا. وكما يقول صايغ فإن “السعي إلى الدولة يحدد عملية صوغ الأهداف ووضع الاستراتيجيات واختيار البنى التنظيمية وكيفية إدارة السياسة الداخلية في أثناء القسم الأعظم من النضال الذي يسبق إقامة الدولة. بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم نفسها مؤسسةً ‘دولانية’ قبل أن تحوز على أرض”. لكن كان للهيئة أرضٌ وقوّاتٌ مسلّحةٌ فعلاً، وبدا أن الشرع عَدَّ إدلب مرحلةَ تجريبٍ للانتقال من التنظيم إلى الدولة.
في هذا التحوّل الحَوْكَمِيّ والهدنة النسبية في إدلب، خرج الجولاني بين الناس وأصبح يظهر أكثر في الأسواق والاجتماعات مع الوجهاء المحلّيين والناشطين. كان الغطاء الشرعيّ للحكومة هو اختيارها من “المؤتمر السوري العام لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة”، الذي عُقد في سبتمبر 2017 بعد شهرين من هزيمة حركة أحرار الشام، وشارك فيه ناشطون وأكاديميون ووجهاء. اختار المؤتمر لجنة تأسيسية سمّت محمد الشيخ أول رئيس لحكومة الإنقاذ في نوفمبر 2017، مع أن نفوذ الجولاني بَقِيَ المتحكِّم بالحكومة.
كان ثمّة تحوّلٌ اجتماعيٌّ قاده أحمد الشرع لتدعيم صورة الهيئة وصورته. فقد أسّس شبكات علاقاتٍ بين الهيئة والمجتمع المحلّي، وترك الباب مفتوحاً لتأثير المجتمع المحلّي في تعديل سلوك الهيئة وخطابها نحو حالةٍ أكثر اعتدالاً ومحلّية. في هذه المرحلة ظهر طموحه السياسي والسعي إلى الاعتراف والشرعية الخارجية، ومحاولة توحيد الصفّ الداخليّ. فكان إقصاء الأجنحة الأكثر تشدّداً عمليةً مستمرّةً، مع تخفيف مظاهر “الحسبة” والرقابة على المجتمع دون إلغائها. وما عدا قمع مظاهرات حزب التحرير وأنصار تنظيم حرّاس الدين خلال الفترة ما بين 2020 و2024، فإنّ الهيئة تعاملت بنعومةٍ نسبيةٍ مع المظاهرات الشعبية التي سبقت معركةَ “ردع العدوان” التي قضت خلال أيّامٍ على حكم الأسد، وإن تخلّلت الفترةَ نفسَها حالاتُ قمعٍ أيضاً. وبلا شكٍّ فإن إغراء الاعتدال والاعتراف المحلّي والخارجيّ كان أكثر تأثيراً في تحوّل الجولاني إلى القائد أحمد الشرع، وهو ما لم يكن ليتحقق لو ظلّ خاضعاً لإغراء الشرعية السلفية الجهادية.
كثيراً ما واجَهَت تحوّلاتُ الخطاب لدى جبهة النصرة ثم جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام حالةً من الهجوم السلفيّ الجهاديّ. مع قدرةٍ عاليةٍ على تماسك الصفّ الداخليّ، سَبَقَ الجولانيُّ أيَّ تحوّلٍ في سياسة تنظيمه ببناء التحوّل الخطابيّ لدى القواعد، ثم التحوّل الخطابيّ المعلَن، ثم التحول على مستوى السلوك والممارسة. وقد سمح هذا بإمكانية الضبط العالية للعناصر في كلّ مرحلةٍ، والذي ظهر جليّاً في مرحلة التحوّل نحو الحكم الوطني بعد سقوط النظام والتعامل مع تنوّع المجتمع السوريّ في المناطق الجديدة.
على مستوى إدارة الأزمات والصراعات، يمكن من تتبّع أسلوب الجولاني في قتال الفصائل وتفكيكها، ثمّ التعامل مع المظاهرات الشعبية ضدّه، معرفة الكثير عن استراتيجية إدارة الصراعات التي طوّرها لاحقاً في معركته الأخيرة الكبرى ضدّ النظام.
لم يكن الجولاني دمويّاً ضدّ خصومه عادةً، وكان يفضّل دائماً حسم معاركه بتفاهماتٍ مع أطرافٍ وتحييد أطرافٍ أخرى، واستعمال التهديد بالقوّة أكثر من القوّة نفسها، إلا حين يشعر بتهديد سيطرته. كما فعل مع حركة الزنكي في ريف حلب الغربي، أو صقور الشام في جبل الزاوية، أو ضدّ المتظاهرين في مدينة معرّة النعمان. واستعمل الجولاني أسلوباً مشابهاً في معركة ردع العدوان التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 وانتهت بسقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، باستعمال القوّة المركَّز، وكسر صفوف النظام الأُولى والتسبّب بحالة صدمةٍ وشعورٍ بالعجز، ما أتاح سلسلةً من الصفقات والتحييد والتفاهمات التي أطاحت بالنظام بأقلّ قدرٍ من الدماء.
كذلك تمكّن الجولاني من إجراء تحوّلاتٍ كبيرةٍ، وببراغماتيةٍ عاليةٍ، دون خسارة صفّه الداخلي أو القسم الأكبر منه على الأقلّ. حتّى وإن حصلت انشقاقاتٌ كثيرةٌ إزاءه، كان أبرزها انشقاق النواة الصلبة لمؤيّدي تنظيم القاعدة الأجانب وتشكيلهم تنظيم حرّاس الدين، إلّا أنه تمكّن من حسمها دائماً. ومع ذلك فهذه البراغماتية واعتدال الخطاب السياسيّ الموجّه للآخَر الأبعد، تقابله نزعة الحسم ضدّ الأطراف الأقرب، والتي تُخشى منافستُها على الشرعية والكوادر.
وفي مرحلة التحوّل نحو الخطاب الثوريّ الوطنيّ يواجه الشرع اختبارَ السيطرة على نزوعِه نحو إقصاء الأطراف التي تتبنّى الخطابَ نفسَه الذي يتبنّاه في هذه المرحلة، وهي الآن الفصائل والمجموعات الثورية المدنية أو العسكرية الأُخرى التي تحاول منافستَه على الشرعية الثورية التي تبنّتها قَبْلَه وضِدَّه سابقاً، وإن كان الشرع يمتلك رصيداً لا يمكن إغفاله بقيادته معركة “ردع العدوان” التي قصمت ظهرَ نظام الأسد.
مجلة الفراتس
—————————
في المؤقّت السوري/ معن البياري
14 فبراير 2025
تتغيّر حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل (مارس/ آذار)، لتتسلّم إدارة البلاد حكومةٌ مؤقتة، يُسمع في دمشق أنها ستكون متنوّعة الألوان. ومع الإعلان عن تسمية أعضاء لجنة مؤتمر الحوار الوطني الستّة، وعقدهم أمس لقاء مع الصحافة، قالوا فيه عن “تمثيليّة” واسعة، مناطقية خصوصاً، للمشاركين في المؤتمر المنتظر، يُفترض أن تعبُر سورية إلى طوْرها الانتقالي بإيقاعٍ آخر، من المنتظر أن يكون مختلفاً، يلمس فيه السوريون تقدّماً نحو شيءٍ من حضورهم في الشأن العام، شعباً متنوّع الشرائح، فيه نخبة متعدّدة الخيارات الفكرية والسياسية، وذلك باتجاه بناء مؤسّسات الحكم وشرعيّته، بانتخاباتٍ رئاسيةٍ ونيابيةٍ ومحلية، وإصدار التشريعات والقوانين والنظم التي تنهض بهذا كله، وأولها إعلانٌ دستوري، قبل الذهاب إلى صياغة مجلس خبراء (أو مجلس تشريعي مصغر أو … إلخ) دستور البلاد الذي يلزم أن يُستفتى السوريون بشأنه، وذلك كله (وغيرُه) بالتوازي مع تعافٍ مشتهى لعجلات الاقتصاد ودواليب الإنتاج ومسارات التنمية والتأهيل في كل القطاعات. وعلى غير ما وصفه محمود درويش مؤقتاً طويلاً ذلك الذي انتظره (أو تأمّله؟) الفلسطينيون بعد اتفاق أوسلو (1993)، وما تأكّد تالياً أنه أكثر من طويل، على ما تبيّنه الحوادث الجارية والمتوقّعة، يُرتجى للسوريين أن يكون مؤقّتُهم قصيراً، سيّما وأنه يتعلّق بإعادة بناء دولتهم القائمة على أسس ديمقراطية جديدة، فبين أيديهم أرضهم، وهم على أرضهم، وفيهم الخبرات في كل حقل وميدان.
وإذ يصحّ القول إن الأصحّ كان إصدار إعلان دستوري، في اليوم الثاني من إسقاط نظام بشّار الأسد، يحسُن عدم التوقّف عند هذا التأخير، مع لزوم ألا يُصبح التأخير، والبطء (أو التباطؤ؟) سمة المؤقّت السوري المرتقب، سيّما وأن “صلاحيات” مؤتمر الحوار المنتظر ليست واضحةً تماماً، وما إذا كانت “توصياتُه” (!) ستكون بمثابة قرارات، أو أنها ستكون في عهدة سلطة رئاسة الجمهورية (في المرحلة الانتقالية) والحكومة المؤقتة المقبلة، ولكليْهما “الحقّ” في الأخذ بمرئيات كلٍّ منهما بشأن ما سيُصدر في البيان الختامي للمؤتمر. ومع التأكيد البديهيّ على أن الدستور هو أبو القوانين، والمرجع الأول في الدولة، ويُفترض أن تختصّ محكمةٌ دستوريةٌ عليا في شأن أي خلافٍ أو تنازعٍ في شأن تفسير أي استخدام له في صناعة هذا القرار التنفيذي أو ذاك، فإن الوضوح في مهمّات المؤتمر (ولجانه) شديد الإلحاح والضرورة.
يتحدّث لصاحب هذه الكلمات التي تنكتب في دمشق أصحابُ رأيٍ وأهلُ اختصاص عن نقصان تفاؤلهم بأن المؤقّت الذي سيعبُر فيه بلدهم (مدّته أربع سنوات على ما قال الرئيس أحمد الشرع لتلفزيون سوريا) ليس مكتمل التفاصيل في هذه اللحظة، وإنّ من الوارد أن ينفّذ أهل القرار الحاكمون في هذه اللحظة من مساحات الغموض إلى فرض ما يريدون، أو أخذ هذا المسار (الدستوري أو غيره) إلى الوجهة التي يستحسنون. بل لا يُخفي بعضُهم توقّعه (أو قناعته!) بأن مؤتمر الحوار الوطني سيكون ديكورياً إلى حدّ ما، أو منتدى حوار ونقاش وبسقوفٍ عاليةٍ في حرّية القول، ولكن بلا نفع منه. على أن هذا التطيّر المبكّر ليس هو المنحى الغالب في تداول النخبة المثقّفة والناشطة في سورية، فوجهة النظر الأعرض هي التي تتبنّى التريّث، وعدم الاحتكام إلى أفكارٍ مسبقةٍ، وعدم الأخذ بالقياس، فلا يُبنى حكمٌ على أمرٍ لم يحدُث على ما حدَث، فالأوْلى في نظر هذا النفر من السوريين انتظارُ الآتي، مع شيءٍ من التفاؤل، وتقدير الأولويات وتقديمها على أي مسألةٍ أخرى. وإذ عاين كاتب هذه المقالة تبايناً في المواقف من تشكيلة أعضاء اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهم ستةٌ بينهم اثنان من هيئة تحرير الشام (المنحلّة)، وسيدتان إحداهما مسيحيّة، فإن لكل وجهة نظر، ناقدة أو مُناصرة، أسباباً من الوجاهة، على أن الرأي الذي سار في المجرى العام هو الذي يغلّب انتظار الأداء، ليكون لكل حادثٍ حديث.
يخوض السوريون، وهم في الشهر الثالث، بعد تحرّرهم من الأسد، في أسئلة المستقبل، وبشأن المؤقّت الذي يعايشونه، بروحٍ ليس ميسوراً الإمساك بتوصيفٍ دقيقٍ لها، فثمّة المتحمّسون شديدو التفاؤل بأن بلداً قوياً ناهضاً معافى حرّاً سيُبنى، وثمّة المتفائلون بحذر ظاهر، وثمّة القلقون، والانتظاريون … وثمّة فئةٌ غير متحدّثٍ عنها بشكلٍ كاف، الخائفون، سيّما في خارج دمشق وريفها. وليس يملك واحدُنا غير أن يتمنّى كل خيرٍ، وكل أمنٍ وأمان، لهذا الشعب الجريح، والمُتعب.
العربي الجديد
—————————-
اقتصاد سوريا الجديدة وتلافي فخّ “المرض الهولندي”/ مهيب الرفاعي
الجمعة 2025/02/14
منذ استيلاء نظام الأسد على الحكم في سوريا، اتسمت العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية بالتعقيد والتوتر وقلة الثقة. إذ شهدت سوريا حالة من العزلة في تعاملها مع مؤسسات أبرزها صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إلا أن سمعة نظام الأسد المتسخة بجرائم ضد الإنسانية وتغلغل نفَس الإرهاب والقمع في مفاصل مسيرته في حكم سوريا، كان له أثر في وضعه ضمن لائحة الغرب السوداء بخانة الدول الراعية للإرهاب، و فرض عقوبات كان من أشدّها حزمة عقوبات عام 1979، مع العمل على توسيع نطاق عمل اللائحة التنفيذية للعقوبات بحيث تضيق الخناق على دمشق، التي لم تلتزم بعدم دعم حركات المقاومة الإسلامية الناشئة في لبنان حينها؛ والتي كان لحافظ الأسد علاقة مصالحية براغماتية معها، لاستخدامها والتلاعب بدعمها بحسب ما يروق لحكمه.
الانغلاق والتضييق
تولى بشار الأسد الحكم عام 2000، على أمل أن يلقى السوريون في “الرئيس الشاب” أملاً في تحسن ظروف معيشتهم والانطلاق نحو الحريات المنشودة والانفتاح السياسي والاقتصادي بعد حقبة من الانغلاق أيام الأسد الأب، وأطلق الابن حينها فكرة ربيع دمشق الذي ما لبث أن تحول إلى خريف وكابوس على السوريين. بدأ الانغلاق الاقتصادي والتضييق على السوريين بحجة وجود العقوبات التي نص عليها قانون محاسبة سوريا الذي أطلقته الولايات المتحدة عام 2003، بحيث يحظر توريد أي من المنتجات الأميركية، ويحظر توريد منتجات خاصة بقطاع النقل البري والبحري والجوي وغيره من التفاصيل.
في هذه الحقبة، واجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، والانكفاء على حكم العائلة وحكم الحزب الواحد، ومنع أية حريات سياسية بالإضافة إلى ملاحقة المعارضين، من دون أي نزعة فعلية نحو الإصلاح؛ الأمر الذي خلق حالة من عدم الجدية في تعامل نظام الأسد مع أي من أطروحات التطوير والتنمية الاقتصادية والسياسية التي قدمها صندوق النقد الدولي عام 2009، عبر لجان استشارية جاءت لتقييم وضع البلاد واختبار مصداقية نزعة هذا النظام نحو التجديد.
عقوبات دولية
لم يكن لسوريا برنامج رسمي مع صندوق النقد الدولي، حيث أبدى نظام الأسد تردداً في التعاون مع الصندوق بسبب اعتبارات سياسية ومخاوف تتعلق بالسيادة والمحاسبة وانفضاح الفشل الاقتصادي في البلاد. في المقابل، عبّر صندوق النقد الدولي عن قلقه تجاه السياسات الاقتصادية السورية، ومشاكل الحوكمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، مما أعاق تطوير أي تعاون فعّال بين الجانبين. تفاقمت هذه الأزمة بعد بدء الثورة السورية وانتهاج النظام نهج القمع كوسيلة لإخماد الثورة، كما أن استمرار الانتهاكات بحق الشعب السوري أدت إلى دمار واسع النطاق ونزوح السكان وأزمة إنسانية كبيرة، مما جعل مهمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية أكثر صعوبة أمام نظام الأسد، حتى وإن بدت آخر أيامه علامات انفتاح على بعض دول المنطقة ورغبة بعودة دمشق إلى “حضن” الجامعة العربية، وبعض الدول الأوروبية، إلا انها لم تكن ترقى لجدية الموقف.
على جانب موازٍ، فُرضت على سوريا عقوبات دولية زادت من عزلتها عن المجتمع المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي. استهدفت هذه العقوبات شخصيات بارزة، وكيانات اقتصادية، وقطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تقييد قدرة البلاد على الحصول على الدعم المالي الدولي للنهوض بالأعباء الاقتصادية للمرحلة بين 2011 و2024، واعتمد النظام على مديونية من إيران وروسيا ومساعدات من حلفاء آسيويين للبقاء على قيد الحياة حينها. ورغم أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب دعماً دولياً كبيراً، إلا ان النظام لم يبدِ جدية في هذا الملف.
ما بعد سقوط الأسد
رغم سقوط نظام الأسد وتأسيس حكومة مؤقتة في البلاد، يتخذ صندوق النقد الدولي موقفاً حذراً تجاه سوريا، وهو موقف يعكس التعقيد السياسي والاقتصادي الذي تواجهه سوريا. عادةً ما يشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على مساعدات مالية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الشفافية. على الأرض، شهد الاقتصاد السوري انهياراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت قيمة الليرة السورية من حوالى 50 ليرة لكل دولار في 2011، إلى أكثر من 14 ألف ليرة لكل دولار في 2024، ما تسبب في تضخم هائل أفقد المواطنين قدرتهم الشرائية. كما تراجعت القطاعات الإنتاجية بشكل حاد، حيث تعرضت الزراعة والصناعة، اللتان كانتا تشكلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى دمار واسع بسبب الحرب ونقص العمالة وتدمير البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه سوريا عجزاً تجارياً كبيراً بسبب تراجع الصادرات واعتمادها المتزايد على الاستيراد، ووضع ميزانية هائلة لاقتصاد التسليح اللازم لمعارك الجيش. في الوقت ذاته، يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا سيما في مناطق النزوح الداخلي، لكن هذه المساعدات لم تكن لتسهم في بناء اقتصاد منتِج وبديل، بل تعزز من الاعتماد على الدعم الخارجي ودعم الدول المانحة. مع وضع اقتصادي بهذا التدهور، فإن أي تدفق كبير للمساعدات المالية، خصوصاً إذا لم يكن مصحوباً بإصلاحات اقتصادية مدروسة، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
مخاطر مالية
إذا لعب صندوق النقد الدولي دوراً رئيسياً في تقديم توزيع المساعدات، فقد يؤدي ذلك إلى تدفق كبير للعملة الأجنبية، مما قد يتسبب في ارتفاع قيمة الليرة السورية بشكل غير مستدام. في حين أن ذلك قد يخفف مؤقتاً من التضخم، إلا أنه سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات السورية، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد. بالإضافة، فإن ارتفاع قيمة العملة قد يدفع العمالة ورأس المال إلى القطاعات غير القابلة للتصدير مثل الخدمات والتجارة بدلاً من الصناعة والزراعة، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تدفق كبير للأموال قد يؤدي إلى توسيع القطاع العام، مما يعزز البيروقراطية ويضعف فرص نمو القطاع الخاص. ومن المخاطر الأخرى، أن تستفيد النخب الحضرية من تدفق المساعدات بينما تظل المناطق الريفية والمناطق الأكثر تضرراً من النزاع تعاني من نقص الاستثمار، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى اضطرابات سياسية.
نموذج الأرجنتين
لجأت الأرجنتين مراراً وتكراراً إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية، وأبرزها في عام 2001، عندما تخلفت عن سداد ديون بقيمة 95 مليار دولار. وفي عام 2018، تلقت البلاد مبلغاً قياسياً قدره 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها لا تزال تواجه تضخماً مرتفعاً وانخفاضاً في قيمة العملة وركوداً. أدت تدابير التقشف إلى تفاقم الفقر، وتبع ذلك عدم الاستقرار السياسي؛ واضطرت الارجنتين في عام 2023 إلى إعادة التفاوض على ديونها مع صندوق النقد الدولي مرة أخرى. يراجع صندوق النقد الدولي برنامج الارجنتين الاقتصادي بخصوص مديونيتها، وتمهيداً لمنحها قروضاَ جديدة لتأتي هذه المراجعات ضمن استراتيجية التقييم بعد التنفيذ، والتي يقوم الصندوق بممارستها مع الدول التي تستقرض مبالغ استثنائية تفوق المبالغ المعتادة للدول؛ كون الأرجنتين أكبر دائن من صندوق النقد الدولي في العالم. نشر صندوق النقد الدولي تقييماً سلبياً لبرنامجه الأخير مع الأرجنتين، الذي بلغت قيمته الأصلية 44 مليار دولار، وهو ثاني أكبر برنامج في تاريخ الصندوق بعد اتفاقه مع الأرجنتين في عام 2018. يُعد هذا التقييم خطوة فنية ضرورية قبل أن يبدأ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مفاوضات للحصول على برنامج جديد هذا العام. ووفقاً لقواعد صندوق النقد الدولي، لا يمكن للدول التي تتمتع بـ”وصول استثنائي” إلى أموال الصندوق، مثل الأرجنتين، التقدم للحصول على برنامج جديد حتى يتم الانتهاء من التقييم اللاحق للبرنامج السابق. تُركز المفاوضات الجارية بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي على تأمين تمويل إضافي وتحديد استراتيجيات لرفع الضوابط المفروضة على العملة ورأس المال، بهدف إعادة دمج الأرجنتين في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وقعت الأرجنتين في فخ “المرض الهولندي Dutch Disease ” -الذي يشير إلى حالة الركود والبطالة التي تلي تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد وارتفاع الطلب على العملة المحلية ارتفاع سعرها أمام العملات الأجنبية؛ الأمر الذي ينعكس على القطاعات الإنتاجية في البلاد- وزاد من تفاقم هذا المرض الديون التي قدمها صندوق النقد الدولي للإصلاحات في البلاد.
رحلة طويلة من الديون
بالنسبة للحالة السورية مع صندوق النقد الدولي وبرنامجه المتخيّل من اقتصاديين سوريين يرون في صندوق النقد الدولي والاستثمارات الخارجية الهائلة ملاذاً آمناً ومهرباً من الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، ويعولون على دخول صندوق النقد الدولي على خط تقديم قروض لمصرف سوريا المركزي؛ فإن ذلك من شأنه أن يفتح باب رحلة طويلة من الديون تتطلب التزاماً عالياً بالنهج الاقتصادي الذي سيرسمه خبراء صندوق النقد الدولي لسوريا على حساب وضع خطط داخلية تتناسب مع مقدرات البلاد ومؤهلاتها الحالية. قد يشمل هذا النهج مجموعة شروط لضمان قدرة الدولة على سداد القروض وتعزيز استقرار اقتصادها. تتمثل بفرض إصلاحات مالية تقشفية، مثل تقليل عجز الموازنة عبر خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، إضافةً إلى إصلاح دعم الطاقة والسلع السوقية عبر تقليل الدعم الحكومي على الوقود والمواد الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يفرض الصندوق تحرير سعر الصرف، ما يعني تقليل تدخل البنك المركزي في تحديد سعر العملة المحلية، وأحياناً تعويمها بالكامل. وتشمل الشروط أيضاً إصلاحات هيكلية مثل خصخصة الشركات العامة، وتحرير السوق، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
الاستثمار في القطاعات الإنتاجية
أما على مستوى القطاع المالي، فقد يطالب الصندوق بتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحسين الرقابة على البنوك، وتقليل الديون المتعثرة. كما يُشدد على الشفافية ومكافحة الفساد، مع فرض إصلاحات تعزز الحوكمة وإعداد الميزانية الحكومية بوضوح. في بعض الحالات، يوصي الصندوق ببرامج حماية اجتماعية لدعم الفئات المتضررة من هذه الإصلاحات، إلا انها تصطدم بإخفاق تنفيذي نتيجة ضعف الخطط والمشاريع والنشاطات الرامية لدعم هذه الفئات. عربياً، خضعت دول مثل مصر عام (2016)، والأردن عام (2020)، لهذه الشروط مقابل الحصول على قروض، لكن هذه الإصلاحات كانت مثيرة للجدل ومحط انتقاد محلي بسبب تأثيرها على الفئات الفقيرة وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم والبطالة، بعد انتشاء مؤقت نتيجة هذه المساعدات والقروض، وبالتالي فشلت وأصبحت هذه الدول مرهونة لسياسات صندوق النقد الدولي بشكل أو بآخر.
في حال قبول صندوق النقد الدولي إمداد سوريا بقروض عاجلة، ربما يبدو من المناسب لتنجب الوقوع في فخ المرض الهولندي، أن يتم توجيه المساعدات بطريقة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بدلاً من مجرد تحقيق استقرار مالي قصير الأجل. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والطاقة، بدلاً من ضخ أموال نقدية مباشرة في السوق. كما يجب إدارة سعر الصرف بحكمة لتجنب الارتفاع الحاد في قيمة الليرة السورية، مما يساعد في الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات. بدلاً من تنفيذ إصلاحات تقشفية فورية، يمكن لمصرف سوريا المركزي دعم نهج تدريجي في إعادة هيكلة الاقتصاد، بحيث يتم تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من دون إحداث صدمة اقتصادية للمواطنين. كما يمكن لسوريا تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال بناء شراكات تجارية مع دول المنطقة ولا سيما تركيا ودول الخليج العربي، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ويحافظ على استقرار الاقتصاد السوري.
المدن
————————————-
تحقق النبوءة الأموية…في حمّامات دمشق/ بثينة عوض
الخميس 2025/02/13
أقف تحت الدش العصري، ساعةً كاملة، أراقب الماء الساخن ينهمرُ على جسدي ووجهي، في تدفقٍ هادئٍ يكاد يعيدني إلى لحظاتٍ أخرى. دائماً ما أشتهي وفرة الماء، وكيف لا؟ وذاكرتي تحملني إلى ما قبل ثلاثين عامًا، حين كنتُ أستحمُّ مع جدتي ونساء القرية عند نبع ماءٍ في إحدى قرى الساحل السوري. كنّ يتبادلن الأهازيج والضحكات والأحاديث المفعمة بالحياة، بينما يمررن صابون الغار في ما بينهن، ويرشُّ بعضهنَ بعضًا بالماء، بلا اكتراث لدين هذه أو تلك، كأنّ العالم بأسره ينحصر في لحظةٍ من الطمأنينة والحرية.
أُجفف نفسي كما كانت تفعل جدتي، ثم أبدأ بتصفح فايسبوك. كتبت صديقتي منى حاج يحيى، المقيمة في دمشق: “أتعرفن كم أنتن محظوظات؟ المعاناة اليومية التي أعيشها كفتاة سورية لا يمكن أن يتخيلها من لم يختبرها. الاستحمام، هذا الفعل الروتيني اليومي، تحول إلى رفاهية باتت صعبة التحقيق. معركة أخوضها يوميًا في مواجهة البرد، وانقطاع الكهرباء، وشح المياه، وغياب التدفئة”.
معركةٌ ضروسٌ يخوضها السوريون منذ عهدِ النظامِ البائدِ وحتى يومنا هذا. يواجهونَ البردَ بخوفٍ، والماءَ الباردَ بخوفٍ أشدّ. يتساءلونَ إن كانَ بإمكانِهم تأجيلَ الاستحمامِ ليومٍ ربما لن يأتي. إنها العودةُ إلى زمنٍ مضى، حيثُ يضطرونَ لتسخينِ الماءِ على الغازِ إن وُجِد، أو على مواقدِ الحطبِ المنتشرةِ في أنحاءِ سوريا، حيثُ لا ماءَ ولا كهرباءَ، فقط بردٌ يفتتُ العظام.
قبل 1300 عام، عندما قرر الخليفة الأموي، الوليد بن عبد الملك، بناء المسجد الأموي، خاطب الدمشقيين قائلاً: “تفخرون على الناس بأربع خصال: بمائكم، وهوائكم، وفاكهتكم، وحمّاماتكم، فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس”.
يُؤكد ابن عساكر في كتابه عن تاريخ دمشق (1169م) أن عدد الحمّامات في المدينة والمناطق المرتبطة بها، بلغ 137 حمّاماً. أما اليوم، فلم يتبقّ في دمشق سوى 8 حمّامات تواصل أداء وظيفتها، وهي حمام نور الدين الشهيد، والقيمرية، والملك الظاهر، والناصري، والبكري، والتيروزي، وأمونة، والشيخ رسلان.
ورغم أن هذه الحمّامات كانت مهددة بالاندثار بسبب تراجع عدد مرتاديها، فقد تحولت الآن إلى مقصد يومي للسوريين، الذين يصطفون في طوابير طويلة من أجل الاستحمام. ورغم أن طريقتهم في الاستحمام قد تكون أقرب إلى الطقوس الفولكلورية التي تشبه استحمام نساء قريتي، إلا أن هذه الحمّامات باتت رمزاً يعيد إحياء ذكريات الماضي، ويجسد جزءاً من التراث السوري الذي يصمد أمام التحديات.
في المقطورات القديمة، تتقاسم النساء والرجال المساحات في تجربة حمّام تتناغم فيها الأجواء التاريخية مع الطقوس اليومية. ماء ساخن ينسكب في جرن حجري، يتبعه عمل المدلّكين و”المُكيِّسين” (نسبة إلى الكيس الخشن أو الليفة التي يُفرك بها الجسد فيخرج ناعماً ومنيراً)، وهم متخصصون في فنون تلميع الجسد.
في أجواء الحمّام التقليدية، تتجمع النساء على مصطبة البهو الحجرية، يعزفن العود في سكينة، غير آبهات بوجود “المُخبرة”، خلافاً لما كان أيام النظام السابق الذي لطالما اعتبر تجمع أكثر من ستة أشخاص خطراً جسيماً، حتى وإن كان ذلك للاستحمام أو عزف العود أو تناول “المجدّرة”. كان النظام يعتمد قاعدة “فرِّق تسُد”، ليصدر قرارات بتشميع العديد من الحمّامات الأثرية التي زارها ملوك ورؤساء وفنانون عالميون.
في تلك الأيام، كانت الحمّامات تتحول ساحة للتجسس، مع تهم جاهزة للأجانب الذين ارتادوا تلك المعالم التاريخية، أو بسبب التحرش، أو مشاكل النظافة، أو دفع الإتاوات. وتحت وطأة هذه الضغوط، تحولت حمّامات عديدة إلى دكاكين أو مستودعات بتهمة “ممارسة الفحشاء”، وفقاً لإحدى وحدات وزارة الداخلية وقتها، في حين تكتمت الشرطة العسكرية على إغلاق أربعة منازل كانت تمارس بين جدرانها “الفحشاء” فعلاً، كونها تتبع لميليشيات إيرانية في المنطقة. كذلك، انتشرت ظاهرة “القبيسيات” بسرعة، فحصلن على كل الدعم الممكن، ما يعكس تحولًا في المشهد الثقافي والاجتماعي في البلاد.
مع ارتفاع أسعار الحمّامات، تحول الاستحمام إلى معركة حقيقية ضد الظروف. فالحمّامات التي تعتمد على المازوت، شهدت تضاعفاً في ثمن الليتر الواحد، أربع مرات، خلال العامين الماضيين. بينما شهدت أسعار المستلزمات، مثل الصابون واللّيف والمناشف، ارتفاعاً بنحو ثلاثة أضعاف. وبينما تتحدث خطط النظام الحالي عن الحاجة إلى ثلاث سنوات لتحسين واقع الكهرباء، أصبح كثيرون يجدون أنفسهم في مواجهة مع الواقع القاسي ودولة جديدة تُبنى على أنقاض دولة خرابة.
وفي تعليق في فايسبوك، قال أحد المواطنين: “خدوا راحتكن، ما ورانا شي أصلاً، تعودنا، مع جزيل الشكر للوليد بن عبد الملك الذي عرف مكانة حمّامات السوق العامة. نعيم الدنيا في الحمّام”. ولعل هذا بالضبط ما دفع مالك أحد الحمّامات التي ظلت تفتح أبوابها للناس والمارّة، إلى وضع لافتة كتب عليها: “أهلاً بكم، ولو زائرين، لأن الحمّام من دونكم يبقى حجراً بلا روح”.
————————
هل غادر بشار الأسد القصر الجمهوري فعلاً؟/ محمد دريوس
14.02.2025
يبدو جلياً أن أحمد الشرع هو مجرد “طقم عمل” أو قناع مسرحي لـ “أبو محمد الجولاني”، يضعه في المقابلات التلفزيونية والحديث للصحافة الغربية، بينما على الأرض ومع بقية المكونات السورية، يتم تفعيل الوجه الأصلي للسلفي غير “الكيوت” على الإطلاق.
كثر من السوريين، وكنت منهم، استبشروا خيراً بفرار الأسد، ظنّاً منهم أن وجوده كشخص كان حائلاً دون قيام دولة المواطنة والتعدّدية، أو على الأقل سيشكل فراره بداية لحلّ قد تحصل معجزة ما ويجترحه السوريون المشتتون، أو على الأقل تفرضه الدول التي يهمّها الشأن السوري، رعاية لمصالحها أو لمصالح ملحقاتها، لكن سرعان ما بدّدت هذه الأحلام الوردية ممارسات سلطة الأمر الواقع الجديد القديمة، وبدا أن ما يحصل مجرد عرض حلقات قديمة من مسلسل بائس، شاهدناه مراراً ولا نعلم كيفية تبديل القناة، لأن الريموت كونترول في مكان لا تصله أيدينا.
أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب
بدا الجولاني، أو ” السيد أحمد الشرع” كما تقدّمه الوظيفة الجديدة، سعيداً للغاية، بأطقمه الجديدة وربطات عنقه المختارة بعناية، وبدا للجميع أن شمساً جديدة قد أشرقت على سوريا، الى درجة أن بعض الأصدقاء ممن يكتبون هنا وهناك، في المواقع التي تموّل من الجهة نفسها التي رتّبت مقتلة السوريين، تحدّثوا عن سماء أكثر زرقة وأشجار أكثر خضرة، وحتى الهواء بدا أنظف كما يقولون، خصوصاً حين حُطِّمت التماثيل الكثيرة، والقبيحة، لحافظ الأسد، فيما ظهر وكأن سوريا تغسل عار أكثر من خمسين سنة من الاستبداد، تمهيداً لدخول عهد جديد، لكن…
لم يمض وقت طويل حتى انتحى “علم الثورة” الذي انضوى خلفه الكثير من “مقاتلي الحرية” والفصائل الإسلامية، وظهر العلم الذي يفضّلونه، والذي يمثّل الأيديولوجية التي تحرّكهم، علم “جبهة النصرة”، وفي بعض الأحيان علم “داعش”، (طبعاً تحت ضغط “الجمهور” أزيل العلم لاحقاً وأزيل هو والأناشيد الجهادية من بث التلفزيون السوري).
يبدو جلياً أن أحمد الشرع هو مجرد “طقم عمل” أو قناع مسرحي لـ “أبو محمد الجولاني”، يضعه في المقابلات التلفزيونية والحديث للصحافة الغربية، بينما على الأرض ومع بقية المكونات السورية، يتم تفعيل الوجه الأصلي للسلفي غير “الكيوت” على الإطلاق.
هذا التلاعب المسرحي المتذاكي، الذي يشبه ما كان يقوم به بشار الأسد، وإن بجدية أكبر وبغير السفسطة السخيفة للأسد الفار، لا ينطلي على أحد، ولن يصدق أحد أن الجولاني وضع أخاه في وزارة الصحة بناء على موهبته الفريدة كطبيب، ووزّع الرتب العسكرية على مطلوبين من جنسيات غير سورية، بناء على مهاراتهم غير المكرّرة كقادة عسكريين، إنما لأن الولاء هو المعيار الأوحد للتعيين، الى درجة أننا نتساءل: من يوجد فعلاً الآن في القصر الجمهوري، بشار الأسد أم الجولاني؟ أو هل غادر بشار الأسد القصر الجمهوري حقاً؟
القناع المسرحي القديم
كانت الأقنعة في المسرح اليوناني من أهم ملحقات “الدور”، وضمّت مجموعة كبيرة من “المشاعر” المتباينة، لإضفاء الحد الأقصى الممكن من التعبير، وبالمجمل تستخدم الأقنعة عندما يراد إضافة مظهر لا يستطيع الممثل، بحكم السن أو الجنس أو المكانة الاجتماعية، إظهاره عبر وجهه العاري، ويحكى أن أول من استخدم القناع (الممثل الروماني روسيوس جالوس) استخدمه لإخفاء عيب في عينه.
لكن القناع الجمهوري السوري في حالة الجولاني أو الشرع يبدو كقناع مركّب فوق قناع، قناع الجهادي السلفي الذي يتعاون مع أجهزة الاستخبارات التي عمّمته وكبّرته ودعمته لوجستياً ليستولي على السلطة، ثم القناع الجديد: الرئيس العاقل، الذي يرغب في الانتقال بدولته الناشئة إلى حيث يرضى عنها الجميع ولو خسر أكثر من نصف أراضيها.
مشكلة قناع الجولاني الذي يريدنا أن نصدّقه أنه عتيق للغاية، أي قبل أن يتكاثف المسرح ويدخل النص المسرحي إلى تعقيدات أبعد من الجدية والهزال. ما زال قناعاً قبل المسرح، قناعاً بسيط لا يقول أكثر مما رسم على سطحه، قناعاً بلا أبعاد عميقة، لا نفسية ولا وطنية حتى، قناعاً يقول: “الجولاني لمن اعتدى والشرع لمن اهتدى”، ضارباً عرض الحائط بكل القيم “الثورية” التي يمكن أن يبنى عليها نص حقيقي أو سردية تجعل الجمهور يخرج من المسرح وهو راض لأنه دفع ثمن تذكرة دموية خلال أزيد من ثلاث عشرة سنة.
ومشكلة القناع الأخرى أنه لا يحتمل تأويلاً يمكن أن نختلف عليه، لا يسمح للمشاهد أن يخطئ في قراءته، وربما لن يكون مفاجئاً إذا باغت الناس السيد الرئيس الجديد، بعد انتهاء العرض، في غرفة الملابس، ليجدوا أن بشار الأسد يكمن تحت قناع الشرع.
النسخة المحسّنة
أبو محمد الجولاني، أو أحمد الشرع في النسخة الأكثر “نظافة” للإعلام الخليجي، القائد القادم من خلفية جهادية، وعلى رغم محاولته التنصّل منها في كل خطابه نحو الخارج غير السوري طبعاً، لم يتوان عن وضع “إخوة الجهاد” في المناصب الأكثر حساسية، كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية ورئاسة الاستخبارات، ومؤخراً وزارة الدفاع، فبينما يظهر للوفود القادمة من الخارج رغبة في التخلي عن هذا الوجه القبيح، الذي جعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعانه ومنظمته على لائحة الإرهاب، وأن سوريا لا تدار بعقلية الفصيل المسلح، لم يستطع أن يضبط الوحش الجائع في داخل منظمته والفصائل المنضوية تحت مسمى هيئة التحرير، فتتالت الانتهاكات القائمة على أساس طائفي، سواء ضد العلويين، “العدو” الأبدي للمنظمات الجهادية السورية، أو ضد المسيحيين “أعداء الملّة”، وما يرد يومياً من أخبار موثقة بالفيديو عن قتل مستمرّ بناء على الهوية الطائفية، والانتهاكات بحق أماكن العبادة.
اثنان وعشرون وزيراً مسلماً جهادياً، بعضهم على قائمة الإرهاب الدولية، ولبعضهم فيديوهات موثقة يرتكبون فيها انتهاكات، اختارهم الجولاني لحكومته الجديدة، ضارباً بعرض الحائط كل ما قاله للوفود الغربية، وللتلفزة التي تحاول “غسله” وتنظيفه من أدران “الإرهاب”، وما إن تمت تسميتهم حتى بدأت بوادر “حرية النصرة” تتوالى: جدل تعديل المناهج الدراسية بما يتناسب مع “الشرع” الإسلامي، انتشار الدعوات العلنية لوضع الحجاب، دعوات لمنع الاختلاط في وسائل النقل والجامعات والمدارس، صرف الموظفين الحكوميين خصوصاً العلويين منهم، وإيقاف صرف الرواتب التقاعدية للعسكريين وذوي الشهداء، الإعدام من دون محاكمة والقتل لمن استطاع إليه سبيلاً… حلّ مجلس الشعب وحلّ الجيش و”هزم الأحزاب وحده”، ثم تنصيب نفسه رئيساً لجمهورية سوريا التي لا تعترف أيديولوجيته أصلاً بحقها في الوجود، وكنا نظنّ أن حافظ الأسد فقط من يفعل ذلك.
ولأننا “لا نحتاج أن نشرب البحر كله لندرك أنه مالح”، كما يقول المثل الإنكليزي، و”المكتوب بيبان من عنوانه”، السوري، فأظن أن كثيراً من السوريين سيندمون على فرحتهم تلك في يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهم إن لم يقولوها علانية اليوم، لأنهم فرحون حقاً بالخلاص من طغمة الأسد الملعونة، فالأيام المقبلة ستجبرهم على ذلك.
العودة
لكل بيت، غالباً، رائحة مميزة تختلف عن البيوت الأخرى، أسميها “رائحة الألفة”، قد تكون ببساطة رائحة المنظفات المستخدمة في البيت أو البهارات المحددة المستخدمة بكثرة في الوجبات، لكن هذا يصنع رائحة مميزة لكل منزل، وكذلك المدن، فيقال إنك عندما تنزل في نيودلهي، وبمجرد خروجك من المطار، تشم رائحة “الكاري” الذي يستخدمه الهنود غالباً في وجباتهم التقليدية.
عندما نزلت في باريس للمرة الأولى، ثم خرجت إلى الشارع باحثاً عن القطار الذي سيأخذني إلى وجهتي، أول إحساس انتابني كان الانقباض. ثمة رائحة أليفة وقبيحة في كل مكان. لا أستطيع تفسيرها أو تبيان ماهيتها. لاحقاً عندما دخلت إلى تواليت عمومي عرفتها. كانت رائحة البول. هواء باريس مشبع برائحة النشادر وبول الحيوانات، وهذا ما أقوله للجميع عندما يسألونني عن باريس: إنها قذرة فقط. للأسف، أشعر أن سوريا كذلك الأمر، وأنني عندما أنزل في مطار دمشق، إذا نزلت يوماً ما، ستهب في وجهي رائحة “الشرع” الكريهة فقط.
درج
—————————————-
العلويون.. القصة الغامضة لحكم سوريا/ محمد شعبان أيوب
14/2/2025
على مدار أكثر من ستين عاما تمكن العلويون الذين اتخذوا من حزب البعث تُكأة للصعود السياسي والاجتماعي والسيطرة على السلطة في سوريا، وتُعد هذه المرحلة “الأسدية” هي الحقبة الذهبية في تاريخهم السياسي الحديث في سوريا والشرق الأوسط منذ ظهورهم كطائفية دينية قبل أكثر من ألف عام، فلأول مرة لا يتمكنوا من حكم أنفسهم في مناطقهم الحصينة في أعالي الجبال الممتدة من الساحل التركي شمالا إلى سواحل اللاذقية وطرطوس جنوبًا فقط؛ إذ أنهم بسطوا هيمنتهم على كامل الأراضي السورية.
التاريخ والاعتقاد
يعود نشأة طائفة العلويين أو النّصيرية إلى مؤسسها محمد بن نصير النُميري البصري، الذي وُلد في العراق في إبان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وقد أصبح ابن نصير جزءًا من حركة عُرفت بالغلو في القرن الثامن الميلادي في مدينة الكوفة.
ووفق عدد من المصادر التاريخية، فقد كان محمد بن نصير شخصية دينية ذات طابع غامض وجاذبية واسعة بين أتباعه خلال القرن التاسع الميلادي، ينتمي إلى قبيلة بني نمير الشيعية التي استوطنت قرب نهر الفرات في جنوب العراق، والتي كانت متحالفة مع قبيلة بني تغلب، العمود الفقري للدولة الحَمدانية الشيعية التي تأسست في حلب خلال القرن العاشر الميلادي، وقد بزغ نجم ابن نصير عندما أعلن عام 850م أنه “الباب” الذي يُولج منه للإمام الشيعي المعصوم.
اليومـ يمثل العلويون ما يقارب 8% من السكان في سوريا، والأمر اللافت الذي يذكره كمال ديب في كتابه “تاريخ سوريا المعاصر” أن بزوغ نجم العلويين بدأ مع الاهتمام الفرنسي بهم من قبل احتلالهم الفعلي لسوريا بعامين كاملين، ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1918 وبعد خروج العثمانيين وهزيمتهم بشهر كامل، وصلت قوة فرنسية صغيرة إلى مرفأ اللاذقية، “وكان هذا الحضور الفرنسي المبكر لافتًا للنظر؛ إذ إن دخول القوات الفرنسية إلى سورية سينتظر عامين إضافيين، فكان خيار البدء باللاذقية دليلا على اهتمام الفرنسيين بالعلويين”.
وعقب الاحتلال الفرنسي الفعلي للبلاد عام 1920 سعت فرنسا إلى تشكيل ما يُسمى بـ”جيش المشرق السوري” التابع لها من عامة السوريين، ولكنها واجهت حينئذ رفضا واسعا من الأغلبية السنية التي تصل ل80% من جملة السكان لأسباب متعددة، كان على رأسها الرفض الوطني للاحتلال، فضلا عن النفور من العسكرية؛ إذ كان لدى السنة ذكريات مريرة من الخدمة العسكرية حيث فقدوا أعدادا كبيرة من أبنائهم في الحرب العالمية الأولى التي دخلوها ضمن الفرق والجيوش العثمانية.
وكان للوضع الاقتصادي الجيد للسنة دوره في ابتعادهم عن الالتحاق بالجيش؛ إذ كانوا يسيطرون على التجارة والصناعة ويمتلكون الإقطاعيات، مما قلل من حاجتهم للانخراط في الجيش. وأمام هذا الرفض للأغلبية السُّنية وجد الفرنسيون أن الطائفة العلوية هي الأنسب لدعم مصالحهم الاستعمارية وترسيخ نفوذهم، لعدة أسباب مهمة؛ إذ كان العلويون يتركزون في منطقة واحدة هي شمال غرب سوريا، على عكس المسيحيين المنتشرين في مختلف أنحاء البلاد. هذا التمركز الجغرافي جعل من السهل التخطيط لتقسيم سوريا وتكوين دولة خاصة بالعلويين.
والأمر الآخر الذي شجع الفرنسيين على ذلك كان بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها العلويون، وحاجتهم للأموال حيث انضم عدد كبير منهم إلى الجيش الفرنسي، ووجدوا فيه فرصة للعمل والحصول على امتيازات مادية واجتماعية.
والأهم من ذلك أن الفرنسيين وثقوا في العلويين واعتبروهم حلفاءهم بهدف تهميش السنة وهو الأمر الذي أكده العديد من الساسة السوريين، منهم الرئيس الأسبق أمين الحافظ في برنامج “شاهد على العصر” على قناة الجزيرة، وهو الرئيس السوري والضابط الذي شارك في انقلاب البعث مع حافظ الأسد ومحمد عمران وصلاح جديد وغيرهم في مارس/أذار 1963.
وقد قام الفرنسيون بعد احتلالهم بتقسيم سوريا إلى أربعة دول؛ واحدة في دمشق والأخرى في حلب والثالثة للدروز في الجنوب والأخيرة دولة العلويين في الساحل السوري، حيث ضمت محافظتي اللاذقية وطرطوس، ورغم هذا التقسيم، فقد فشلت الدولة العلوية الصغيرة بسبب افتقارها إلى العمق الجغرافي والاقتصادي؛ إضافة إلى الضغوط المتزايدة من القوى السنية، وعلى رأسها الكتلة الوطنية، التي طالبت بإعادة توحيد الأراضي السورية.
وعلى الرغم من هذا الفشل، قدم بعض وجهاء العلويين طلبا للفرنسيين يدعون فيه لاستمرار الفصل بين دولة العلويين وسوريا، وكان من بين الموقعين على هذا الطلب سليمان الأسد، جد الرئيس السابق حافظ الأسد، وقد كشفت فرنسا عن هذه الوثيقة في عام 2012 إبان الثورة السورية، ولا تزال الوثيقة التي تحمل هذا الطلب محفوظة في الخارجية الفرنسية تحت الرقم 3547 لسنة 1936.
والحق أن جيش المشرق الفرنسي في سوريا كان يعتمد بشكل كبير على رافد لا ينقطع من الجنود العلويين، وقد تشكلت غالبية قواته من 10 كتائب مشاة من العلويين، وعندما تم تأسيس الجيش السوري بعد جلاء الفرنسيين عام 1946، تم دمج جيش المشرق الفرنسي في الجيش الوطني الجديد، مما أدى إلى انتقال هذه النسبة الكبيرة من الضباط والجنود العلويين إلى الجيش السوري. وهكذا، تشكلت كتلة علوية قوية داخل الجيش، حيث بدت وكأنها “جيش داخل جيش”.
ترقب الفرص
كان حلم العلويين بعد الاستقلال وجلاء المحتل إعادة تأسيس دولة العلويين، ولكن برؤية أكثر توسعا وإحكاما، حيث خطط بعض الضباط العلويون لضم مدينة حمص ومساحات واسعة من محافظتها، لتوفير العمق الجغرافي لدولتهم، ولتحقيق ذلك كان الهدف يتمثل في تهجير السكان السنة من هذه المناطق، ليصبح العلويون هم الأغلبية السكانية، ما يمهد الطريق لتأسيس دولتهم المزعومة بقوة أكبر وهذا ما قاموا به بالفعل كما سنرى.
في ذلك الوقت كانت كتلة ضخمة من الجيش السوري في منتصف القرن العشرين متأثرة بنفوذ حزب البعث الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو ما دفع الضباط العلويين للانتماء إلى كلا الحزبين لضمان البقاء في صف المنتصر، واتخاذه ستارة لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية.
ولكن كما يوضح باتريك سيل في كتابه “الأسد .. الصراع على الشرق الأوسط” تغيّرت المعادلة بعد مقتل العقيد عدنان المالكي عام 1955 وكان رجلا بعثيا على يد جندي علوي ينتمي للحزب السوري القومي، الأمر الذي أدى إلى اضطهاد كل من ينتمي لهذا الحزب، وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في انتقال معظم الضباط العلويين إلى حزب البعث، وفي هذه المرحلة انتقلت قيادة الضباط العلويين من غسان جديد الذي قُتل عام 1957، إلى شقيقه صلاح جديد، الذي أصبح الشخصية المحورية في قيادة وتحريك هؤلاء الضباط.
خلال الفترة بين 1949 و1958، عانت سوريا من عدم الاستقرار السياسي نتيجة سلسلة من الانقلابات العسكرية المتكررة التي كان يقودها الضباط السنة ضد بعضهم البعض، وكل ضابط كان يصل إلى السلطة كان يقوم بفصل الضباط السنة المنافسين له واضطهادهم وسجنهم ونفيهم، ما فتح المجال أمام الضباط العلويين لتعزيز وجودهم، ووفق هذه التطورات تمكن هؤلاء من تقديم أنفسهم كعامل توازن يمكِّن أحد الأطراف من التغلب على الآخر، في حين أن الضباط السنة لم يعتبروا هؤلاء الضباط المنتمين إلى أقلية خطرا على منصب الرئاسة أو قيادة الجيش، مما ساعد العلويين على تعزيز نفوذهم بشكل تدريجي.
في عام 1958، ومع قيام الوحدة بين مصر وسوريا تحت مظلة الجمهورية العربية المتحدة، تم حل جميع الأحزاب السياسية وفقا لما اشترطت القاهرة، لكن الضباط العلويين تمكنوا من الحفاظ على هيكلية سرية خاصة بهم، استطاعوا من خلالها ملء الفراغ الذي تركه حزب البعث بعد حله مؤقتا، وكانت هذه الهيكلية بقيادة اللجنة العسكرية التي ترأسها صلاح جديد، وضمت شخصيات بارزة مثل حافظ الأسد، ومحمد عمران، وعبد الكريم الجندي (وهو إسماعيلي).
وبعد انفصال سوريا عن مصر عام 1961، استغلت اللجنة العسكرية الرغبة الشعبية العارمة في إعادة الوحدة إلى جانب الدعم الكبير من ضباط الجيش، لتعزيز نفوذها وإعادة تنظيم صفوفها، مما مهد الطريق لزيادة تأثيرها في الحياة السياسية والعسكرية في البلاد.
انقلاب علوي
وفي شهر مارس/أذار عام 1963، تمكنت اللجنة العسكرية التابعة لحزب البعث من استغلال شعار الوحدة العربية لإقناع الضباط الناصريين ومؤيدي الوحدة، وعلى رأسهم لؤي الأتاسي ومحمد الصوفي وزياد الحريري، بالتعاون لتنفيذ انقلاب عسكري بهدف إعادة الوحدة بين سوريا ومصر، وبالفعل نجح الانقلاب في إيصال هؤلاء الضباط إلى السلطة، ولكن بينما انشغل الضباط السُّنة بالمناصب الشكلية، ركز الضباط العلويون على السيطرة على مفاصل الجيش والدولة.
تم تعيين لؤي الأتاسي رئيسا للجمهورية، ومحمد الصوفي وزيرا للدفاع، وزياد الحريري رئيساً للأركان، في حين كانت اللجنة العسكرية العَلوية تعمل بذكاء لتثبيت قبضتها على المواقع الاستراتيجية؛ حيث سيطر صلاح جديد على مكتب شؤون الضباط، ما مكنه من نقل وفصل واستقطاب الضباط بما يخدم أهدافه، كما تولى حافظ الأسد قيادة القوات الجوية والمطارات، بينما تسلم محمد عمران قيادة القوات البرية، حيث عُين قائدا للواء الخامس في حمص واللواء المدرع السبعين.
وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، نجح الضباط العلويون في بسط نفوذهم على الجيش والدولة، وفي يوليو/تموز 1963، وبينما كان الرئيس لؤي الأتاسي يجتمع مع جمال عبد الناصر لمناقشة إعادة الوحدة، شن الضباط العلويون حملة لإقصاء الضباط الناصريين ومؤيدي الوحدة، ومن اللافت أنه قد شارك في هذه الحملة أمين الحافظ وزير الداخلية آنذاك، وهو ضابط سني، والذي تولى لاحقا منصب رئيس الجمهورية، ومع ذلك، لم يستمر أمين الحافظ طويلا في منصبه، فقد اتخذه الضباط العلويون مجرد ستار لتحقيق أهدافهم، حيث تم الإطاحة به في انقلاب عام 1966 بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد، حيث وضعوا نور الدين الأتاسي كواجهة لرئاسة سوريا.
الأمر الذي يلحظه الباحث ريموند هينبوش في دراسته “علوّيو سورية وحزب البعث” أن السلطة العلوية الجديدة فتحت الباب أمام عامة العلويين من النزول من جبال وقرى النصيرية في الساحل إلى المناطق السهلية، وشجّعوا على هذه الهجرة خاصة إلى وادي الغاب وسهل عكار ومناطق في حمص يقول: “تضمن الإصلاح الزراعي في ستينيات القرن العشرين الاستيلاء على أراض زراعية شاسعة من أيدي النُّخب المدينية السُّنية والمسيحية غالبًا، وإعادة توزيعها على السكّان العلويّين… واستكملت تلك الإجراءات الإستراتيجية التي وضعها حافظ الأسد لتقويض المجتمعات السُّنية العربية والكردية التي سكنت تلك المناطق وعارضت نظامه”.
على المستوى السياسي وفي هذه المرحلة الجديدة، نجح صلاح جديد وحافظ الأسد في إقصاء زميلهم محمد عمران، أحد أعضاء اللجنة العسكرية العلوية بسبب اعتراضه على بعض الإجراءات التي اتخذوها، مما عزز من نفوذهما، وفي تلك المرحلة تولّى حافظ الأسد منصب وزير الدفاع، بينما ارتكب صلاح جديد خطأ استراتيجيا بتركه قيادة الجيش لحافظ الأسد وانشغاله بإدارة الدولة والحزب.
الأسد والعصر الذهبي للعلويين
في خلال ثلاث سنوات من تولي حافظ الأسد منصب وزير الدفاع، تمكن مِن إحكام سيطرته الكاملة على الجيش السوري، وقد نفذ انقلابه الشخصي في عام 1970 الذي أطاح فيه بـصلاح جديد والرئيس نور الدين الأتاسي، وألقاهما في السجون، وفي عام 1971، أعلن حافظ الأسد نفسه رئيسا للجمهورية، مستهلاً مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
في كتابه “الصراع على السلطة في سوريا”، يوضح المؤرخ والدبلوماسي الهولندي نيقولاس فان دام أن حافظ الأسد، بعد استيلائه على السلطة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، اعتمد بشكل كبير على مجموعة من الضباط الموالين له، الذين شغلوا مواقع إستراتيجية بارزة في القوات المسلحة، ويشير فان دام إلى أن معظم هؤلاء الضباط كانوا من الطائفة العلوية، أما الضباط المنتمون إلى طوائف دينية أخرى، ورغم توليهم مناصب عسكرية رفيعة، فقد كانت أدوارهم شكلية فقط، حيث لم يكونوا في موقع يسمح لهم بتهديد سلطة الأسد.
ويضرب فان دام أمثلة للتأكيد على هذه الفكرة؛ فاللواء ناجي جميل، وهو ضابط سني من محافظة دير الزور، ترأس سلاح الجو السوري من نوفمبر/تشرين الثاني 1970 وحتى مارس/آذار 1978. ومع ذلك، لم يكن بإمكانه استخدام سلاح الجو بفعالية في مواجهة أي تهديد عسكري ضد حافظ الأسد؛ لأن الضباط العلويين كانوا وحدهم من يسيطرون على القواعد الجوية الرئيسية في البلاد.
وهذا الأمر ينطبق على ضباط سُنة آخرين، مثل اللواء مصطفى طلاس، الذي عُين وزيراً للدفاع في مارس/آذار 1972، وكذلك اللواء يوسف شكور، وهو مسيحي من طائفة الروم الأرثوذكس، الذي تولى منصب رئيس الأركان لاحقا، فقد كانوا في مناصب مرموقة من حيث الشكل، ولكن مفاصل القوات المسلحة ووظائفها الإستراتيجية كلها بيد الضباط العلويين.
وإذا كان الأمر سار بهذه الطريقة على مستوى الضباط والقيادات العسكرية في الجيش، فإن ريموند هينبوش في دراسته السابقة يرى أن الإستراتيجية ذاتها طُبقت على مستوى الجنود وضباط الصف في الجيش أيضًا؛ صحيح أن المجتمع السني أدّى دورًا بارزًا في القوات المسلحة السورية منذ تأسيسها غير أن المجندين السنة القادمين من المناطق الريفية مثل قرى حوران والمناطق المحيطة بحمص ونهر الفُرات كانت فرصتهم أقل في الترقي المهني في الوحدات المدرّعة والقوى الجوّية ووحدات النُّخبة في الجيش السوري مثل الفرقة الرابعة سيئة السُّمعة، التي بقيت تحت سيطرة قادة علويين فضّلوا تقليديا تجنيد أفراد علويّين.
وبعد حرب 1973 وبفضل هذه الخطوات أدرك حافظ الأسد أنه بات يمكنه تحقيق سيطرة العلويين على كامل سوريا، ولكن بشرط اتباع سياسة صارمة تعتمد على القمع والقبضة الحديدية وسحق السنة وهو ما حدث في العديد من المجازر في جسر الشغور وحماة وغيرها، ورغم هذا الانتصار العلوي الضخم والإستراتيجي، اتخذ بعض العلويين الآخرين مبدأ الرفض لهذا النهج؛ مُفضلين فكرة إقامة دولة علوية مستقلة خاصة بهم، وكان من بين هؤلاء كان الوزير والأديب العلوي المعروف بدوي الجبل.
عقب وفاة حافظ الأسد عام 2000، استمرت هيمنة العلويين على السلطة بارتقاء الابن بشار الأسد في عملية توريث حكم الجمهورية، ويلحظ ريموند هينبوش إلى أن الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011 وانشقاق العديد من الضباط السُّنة رفيعي المستوى وانضمامهم للجيش السوري الحر مثل عبد الرزاق طلاس، ومناف طلاس الذي فر هاربًا بعد عجزه عن إخماد المعارضة في مدينة الرستن بحمص، جعل نظام بشار الأسد يُبقي الكتائب ذات الأغلبية السُّنية داخل ثكناتها لشكّه في ولائها، رغم إدراكه استنزاف احتياطي الجنود العلويين، لهذا السبب كان بطيئًا في مكافحة الثورة، وعانى صعوبة كبيرة في استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها المعارضة.
ومنذ عام 2012 سرّع النظام من تجنيد علويي الساحل، واستدعى تقريبا كل الذكور الذين تترواح أعمارهم بين 20 و 40 سنة للخدمة العسكرية والقتال في محاولاته تدارك عدم التوازن المجتمعي داخل قوات الأمن، وتعويض الخسائر التي تكبدها الجيش، وقد تقبّل العلويون هذا الانضمام للقتال بكثافة وسرعة أكبر مقارنة بالسنة والدروز والمسيحيين كما يقول هينبوش.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 انهار حكم عائلة الأسد، وقد حمل في ثناياه انهيارا واضحًا للسيطرة العلوية على السلطة في سوريا التي استمرت قرابة الستين عاما، وهي قصة لافتة رأينا فصولها وأحوالها التي بدأت بدعم من المحتل الفرنسي، واستغلال من الضباط العلويين لكثرة الانقلابات العسكرية التي قادها الضباط السنة وصراعهم على السلطة في البلاد، ليستأثروا وينفردوا بالمشهد.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية
————————————
عودة سوريا إلى عمقها العربي: ضمانة لحماية الأمن القومي العربي/ عصام هيطلاني
2025.02.14
سوريا، على مدار تاريخها، كانت عنصراً محورياً في تعزيز وحدة العرب ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ولكن الحقبة التي حكم فيها الطاغية بشار الأسد شهدت تحولاً جذرياً في هذا الدور، وخاصة بعد اندلاع الثورة السورية، التي ألقت بظلالها على استقرار البلاد وأثرت بشكل كبير على مكانتها في المعادلة العربية والدولية.
مع إسقاط النظام السابق، أصبحت سوريا في حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية، ما جعلها عرضة لصراع العديد من المشاريع الإقليمية والدولية التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفته الأزمة. هذه التغيرات أظهرت بوضوح الحاجة الملحة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، ليس فقط لصالح سوريا نفسها، ولكن أيضاً من أجل تعزيز وحدة الصف العربي والدفاع عن مصالحه بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
إن استعادة سوريا لموقعها الطبيعي في قلب العالم العربي، خاصة بعد تراكمات هذه الأزمة العميقة، تظل ضرورة استراتيجية لتوحيد الجهود العربية وإعادة تأكيد الدور الفاعل لسوريا في استقرار المنطقة ونموها. ففي ظل التصريحات الواضحة والصريحة للرئيس الانتقالي “أحمد الشرع “، التي رسمت خارطة طريق للسياسة الخارجية، أكدت بشكل واضح وصريح، على أهمية العلاقات العربية، لا سيما مع دول الخليج، حيث يصبح من الواضح أن إعادة بناء الثقة بين سوريا والدول العربية تشكل خطوة ضرورية لإعادة استقرار المنطقة. كما أضاف أحمد الشرع أن “الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام، ولن يُسمح بتصديرها إلى أيّ مكان آخر، فسوريا لن تكون منصَّة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان، بل تسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع الدول العربية.
إن عودة سوريا إلى الصف العربي تمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها بشكل إيجابي وفعال من قبل الدول العربية، وخاصة دول المشرق العربي. فالمملكة العربية السعودية، بحكم موقعها وثقلها الاقتصادي في العالم العربي والساحة الدولية، تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم سوريا لإعادة إعمارها واستعادة استقرارها. في هذا السياق، يمكن لدولة قطر أيضاً أن تلعب دوراً محورياً في تنشيط الاقتصاد السوري والمساهمة في حل العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. إضافة إلى ذلك، يمكن للإمارات العربية المتحدة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا ودول الخليج، مما يسهم في استعادة سوريا لدورها الحيوي في العالم العربي والمنطقة، حيث تمثل سوريا بوابة العرب إلى القارة الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط بحراً، وعبر تركيا براًـ
بعد سنوات من الحرب والدمار، تحتاج سوريا إلى دعم وسخاء اقتصادي عربي لتجاوز أزمتها وتحقيق استقرار طويل الأمد. ورغم أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، فإن هناك فرصاً هائلة للإصلاح الاقتصادي.. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر خطوات عملية لتأهيل القطاعات الاقتصادية والحكومية التي تعاني من التخلف والترهل والتدهور.. وهذا بالطبع يستدعي شراكات عربية ودولية فعّالة، إذ يمثل التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، ركيزة أساسية لتحقيق هذا التقدم. علاوة على ذلك، فإن التحالفات الاقتصادية التي تعتمد على الاستثمار في القطاعات الأساسية مثل النفط والزراعة والطاقة يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز قدرة الدولة على استعادة مكانتها السياسية والاقتصادية في المنطقة.
إن العودة إلى تعزيز العلاقات بين سوريا والدول العربية تشكل فرصة جديدة للعرب لدعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. إذ إن التحفظ والابتعاد عن سوريا أو تجاهلها، يعني تركها عرضة للمشاريع المتصارعة في المنطقة، مما يعكس سلباً ويزيد الأمور سوءا على الأمن العربي والإقليمي، لذلك من الضروري أن تتخذ الدول العربية، خصوصاً الخليجية منها، المبادرة لتسريع عملية التنسيق والتعاون مع سوريا لمواجهة التحديات المشتركة.
علاوة على الفوائد الاقتصادية والسياسية، فإن عودة سوريا إلى عمقها العربي تحمل أهمية استراتيجية في التصدي للسياسات الإسرائيلية التوسعية والعدوانية. فالتعاون العربي يمكن أن يسهم في تشكيل لوبي عربي قوي يدعم سوريا في الساحة الدولية من خلال الضغط السياسي القائم على فضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي السورية.
إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق والتفاهم السياسي العربي تجاه سوريا، يشكل ضغطاً على الإدارة الأميركية القادمة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، مما قد يعزز فرص الضغط على القوات الإسرائيلية للانسحاب من الأراضي السورية. كما يمكن لهذا التفاهم أن يسهم في إقناع الرئيس الأميركي بإعادة تقييم وجود القوات الأميركية في سوريا، وبالتالي الضغط على الأكراد للدخول في العملية السياسية، مما يسهم في تسريع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. وبالتالي، تحقيق وحدة الأراضي السورية واستعادة سيادتها على كامل ترابها الوطني.
إن إسقاط النظام البائد في سوريا، قد حقق مكسباً هاماً للأمن القومي العربي، إذ أسهم في إخراج إيران وأذرعها من سوريا، إضافة إلى إغلاق آفة خطيرة نشرها طاغية النظام المخلوع، حين حول سوريا والمنطقة إلى مسرح للجريمة وزراعة المخدرات وتصديرها إلى دول الجوار، وخاصة الخليجية.
لا شك أن هناك بعض التحفظات لدى شرائح من الشعب السوري بشأن أسلوب إدارة العهد الجديد، إلا أنه من المهم أن ندرك في الوقت ذاته صعوبة وخطورة الظروف الانتقالية التي تمر بها السلطة. لذلك، لابد من تجنب لغة التصعيد والتحدي والمواجهة بشأن تلك التحفظات، بل يجب اعتماد لغة الحوار الحكيم وصولاً إلى المشاركة الفعّالة في المؤتمر السوري الوطني المزمع عقده قريباً في دمشق والذي من المنتظر أن يؤسس لعقد اجتماعي جديد يضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب السوري في بناء سوريا الجديدة.
في النهاية، إن استعادة سوريا لدورها المحوري في المنطقة يعزز من قوة العرب في مواجهة التحديات المستقبلية ومصيرهم وأمنهم المشترك، وخاصة التصدي لمشروع الكيان الإسرائيلي القائم على التوسع والاحتلال، الذي يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي، انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه الدول العربية الأخرى. لذا، لا بد من تمتين العلاقات الاقتصادية، الثقافية والسياسية بين سوريا والدول العربية بشكل عاجل وعلى أسس متينة، لتشكيل سدّ منيع أمام محاولات تحقيق مشروع الكيان الإسرائيلي الذي يطمح إلى التوسع من النيل إلى الفرات.
لذلك، لا بد من وضع خطط استراتيجية واتفاقيات ومعاهدات شاملة وعادلة ومتوازنة، تضمن التنسيق العربي في سوريا، وليس التنافس والتناحر في الساحة السورية، لتجنب الانزلاق مجدداً في أتون الصراعات والتحديات الجانبية التي قد تضر بالاستقرار العربي. اليوم، يملأ الشعب السوري الأمل والبهجة بعودة سوريا إلى عمقها العربي، مما يعزز قدرة العهد الجديد على التوجه بكل ثقة وطمأنينة نحو هذا العمق. وهذا التوجه لن يلبي فقط طموحات وآمال الشعب السوري في استعادة دوره العروبي، بل يمثل أيضاً الأمل في انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية من دون استثناء. ومن خلال هذا التوجه، سيتمكن الشعب السوري بالتعاون مع عمقه العربي من بناء دولة مستقرة وآمنة، تكون نقطة انطلاق جديدة، وأملا متجددا بتحرير الاراضي العربية المحتلة وبناء مستقبل عربي طموح وواعد.
تلفزيون سوريا
—————————–
الممتعضون من الشرع.. ماذا لو كان الوزراء من مثقفينا؟/ أحمد الشمام
2025.02.14
تحدثت السيدة الأميركية من أصل سوري د. ميساء قباني، عن دعوة تلقتها من صديق لحضور ندوة عقدتها منظمة أوروبية منذ أعوام في النمسا، للتشاور حول كتابة دستور سوري معد غربيا، مع خلطة مدروسة من الشخصيات والجماعات المدعوة وانتماءاتها، حيث كانت ثلة من الناشطين باسم الأقليات تزيد عن 80 في المئة، مع تغييب متعمد لكتلة كانت الحامل التاريخي للدولة والمتن الحقيقي للثورة، وعندما اعترضت على طريقة التمثيل تم طردها من قبل الراعي الألماني هناك فردت له أنا سورية وأنت من يجب أن يخرج فهذا دستور بلدي، وعندما حاججت بعضهم عن شطح مشروع الدستور ونمطه الأوروبي المتعالي على ثقافات المجتمعات المشرقية، قيل لها سنفرضه فرضا.
بين فرض دستور مدعوم خارجيا لدى نخبة تدعي تمثيل شعبها، وفرض شرعية دستورية، أو شرعية ثورية مع مراعاة البيئة الدولية الممسكة بتلابيب الاقتصاد السوري وشرعية الحكم الجديد؛ لفك الحصار عن الشعب السوري تنابذ السوريون في مواقفهم، وتوزع النقد لسلطة دمشق بين طامح بالتعددية والدولة لكنه استعجل الحقوقي على الطارئ؛ إذ لم يرفع السوريون ركام بيوتهم، وظهرت فئة من الممتعضين من السلطة الجديدة تحولوا لقنوات رصد ومتابعة أشبه بصفحات حقوق الأنسان التي ابتدعها شباب الثورة بمقدراتهم البسيطة ظانين أن العالم سيسمعهم.
يشكل الممتعضون النسبة الأكبر لجهة موقفهم الأيديولوجي من الإسلام السياسي؛ فابتلوا بإسلام جهادي طور نفسه ومنظومته في الحاكمية والدولة وفقا لما صدر، كما شهدنا من تطمينات وسلوك وخطاب رسمي؛ مع كثير من التحفظات التي لم تتورط بالقراءة التقليدية التنميطية لسلطة دمشق. ويشكل ضحايا اليسار الذي ما عاد يستطيع أن يعرف نفسه سوى بنديته للإسلام مع بعض ضحايا النزعة الأقلوية فيه.
تحضر في هذا السياق مقولة إن الشعوب تجاوزت نخبها في الربيع العربي لكن الأخيرة امتطت الحراك وجيرته، لنفهم المعادلة قليلا، لنجد أن ما شهدناه من تحرير سوريا كان فعل نسق لم يكن من بين تلك النخب التي استهلكت نفسها في مؤسسات تمثيل الثورة وفشلت ولم تطرح مشروعا وطنيا يجتذب أبناء سوريا من ذوي التدين الشعبي، فذهب أولئك الشباب إلى توجه إسلامي وجد فيه ضالته رغم كثير التحفظات عليه، فشكلت جوقة الراقصين على دماء الشعب السوري، يضاف إلى تلك نخب ظهرت على حساب الثورة كحزمة منظمات المجتمع المدني وليس ببعيد اجتماع 3500 منظمة في باريس منذ عام ونيف ولم نجد لها فعلا يذكر، وصاروا ندابين على سوريا، كما ظهرت ثلة من المكوعين أيضا يطالبون سوريا أن تكون سويسرا بغمضة عين؛ رغم تبجحهم بحيادهم السياسي وصاروا الآن يريدون حصة من السياسة والدولة، ومنهم من حمل طيفا واسعا من مطالب حريات، وحقوق إنسان ذات النمط الغربي، وقضايا عالقة منذ خمسين عاما أو لم تكن قد خلقت بعد؛ وتكومت بوجه الدولة الجديدة، تلك التي قال عنها د. منصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق في رسالته لثوار سوريا؛ أن كثيرا من القضايا العالقة لعقود ستتخم أبواب السلطة بما ليس له حل آني، ويقتضي التأجيل قبالة أولويات الأمن واستقرار الدولة وإعادة المهجرين إلى ركام بيوتهم، حتى أن مهجرين بعشرات الآلاف يحلمون بمن يعينهم في إزاحة ركام بيوتهم لنصب خيمة النزوح على الأطلال.
لابد إذن من تجشم عناء السير في حقول الألغام لتفكيك حساسيات تكرس شرذمة الشعب السوري النازع نحو الحياة والتشارك؛ ويضيع صوت الحقيقة في غمرة ذاك الضجيج المصطنع؛ لذا فإنا قبالة ذلك لن نتحدث عن الرئيس أحمد الشرع، بل عقد مقارنة بسيطة عن الطرف الأضعف والأقل تماسكا وهي السيدة عائشة الدبس، التي نختلف مع رؤيتها الناجمة عن بيئة ثقافية تمثلتها في إدلب المحافِظة، ومما ليس منه بد الإقرار بحاجة الفكر الديني إلى بيئة تناسب المرحلة، ورغم تنميطها المتعمد من قبل كثير ووصفها بالانغلاق، سنذهب لضرب أمثلة الانفتاح في جهة مقابلة عبر مسيرة الثورة حول عينة واسعة ممن يعد من المثقفين في المجال الثقافي السوري، وسيكون علينا وضع احتمال أن يكون أي منا نحن المثقفين في محلها وزيرا، فالمثقفون هم أكثر الناس تعلقا بالسلطة، كما أن كثيرا من المواقف لدى نخبنا تجاه السلطة الجديدة تتعلق بطموحهم بالسلطة لدرجة أعمت أبصارهم عن حساسية المرحلة، خصوصا وأن أحدهم فضح نفسه على شاشة تلفزيون سوريا وقال أن توثيقا لـ 180 حالة تجاوز تم إرسالها للمبعوث الأممي؛ ما يعني تثبيط سعي السلطة بدمشق لتخفيف حزمة العقوبات الدولية المفروضة على الشعب السوري، كما يعد جزء من هذا الرهط لمؤتمرات في عواصم شتى تشمل جموع الممتعضين والرافضين للتدخل الخارجي سابقا وهم الآن معه، ولا نغفل مجموعة مهمة ومحيدة من مثقفينا؛ تسعى جاهدة لتفكيك حروب الثنائيات وطبولها التي تقرع في المجتمع السوري، في محاولة بناء خط ينحو بالجميع للتعاون والتشارك وحفلت بنقد بيئاتها الاجتماعية تنتمي لشتى الطوائف.
لدينا مثقفون كثر معارضون علمانيون بخلطة متنوعة جدا من لائكية فرنسا إلى علمانية ألمانيا، أو بريطانيا ذات الجذور الدينية، ونسويين ونسويات، إضافة لعلمانيي الأقلوية، وضحايا الخطاب الماركسي المتخشب، مضافا لهم المنبطحون المؤمنون بالحداثة الغربية كنمط مستورد لابد من تطويع مجتمعاتنا وفقا لقوالبه؛ والمؤمنون باستحالة وجود حداثة مشرقية/ عربية/ مسلمة، وحتى بوذية. واستحوا أن يعلنوا تكويعهم في بعض مما طالبوا به بعد استلام ترمب؛ الذي رفض كل ما تم ترويجه من شذوذ جنسي وقضايا جندرية، ووعد بمحاسبة كل من يعمل به من مؤسسات تعليمية وطبية.
إن عينة من المنفتحين ثقافيا والتنويريين؛ التي من الطبيعي أن تترشح لتسلم أحد الحقائب في الحكومة القادمة، تفيد في عقد مقارنة مع الحلقة الأضعف في نسق الحكومة الحالي نذكر منها:
مثقفة ناشطة في المهجر امتعضت من تحدث امرأة محجبة في أروقة الأمم المتحدة عن معاناة المعتقلات السوريات؛ وصرحت أن وجود محجبة في مكان كهذا يوحي بأن الثوار أو السوريين من لون واحد. مثقفة أخرى وناشطة صرحت عند ترشح فيلم سوري للأوسكار وحضور المخرج مع زوجته المحجبة “بأن ذلك مخجل في عالم الأضواء والأوسكار وكان عليها أن تخلع حجابها أو ألا تحضر”.
مثقف نسوي من ضحايا العلمانية الأقلوية يدعو في حملة دعائية للاعتراض على إدارة فيس بوك إثر تعيين اليمنية توكل كرمان باعتبارها كانت في حزب قريب من الإخوان المسلمين، ورغم نسويته لم يفكر في ميليشيات قسد الكردية وهي تخطف القاصرات لتجنيدهن؛ وهرع إلى مؤتمرها – مسار الديمقراطية- في بروكسل قبل تحرير دمشق بشهر. مثقفة وناشطة تلعن الثورة التي جاءت بالمهاجرين الذي فضحوها بالصلاة في مكان عام صباح العيد؛ كانت قد هيأته البلدية في إحدى المدن الألمانية كترحيب بالتعدد الديني ودعوة للتشارك، مثقف يساري ومعتقل سابق ومن صفوف اليسار التاريخي العتيد؛ يكتب على صفحته قبل يومين من بدء رمضان ها قد أتى رمضان وسنغلق أنوفنا وهي تشم رائحة ال… من أفواه المسلمين الصائمين. ما يدل في الحقيقة على مظلمة جديدة تعرض لها المسلمون في سوريا تختلف عن المذابح والمجازر التي ارتكبها النظام البائد، هي مظلمة ثقافية مورست ضد الإسلام والمسلمين من قبل مثقفين كانوا ضد الدكتاتور وتوحدا مع نسق آخر من أزلام الدكتاتور قبل سقوطه وتكويعهم، إنه إعلاء الأيديولوجيا على الثورة والموقف من الأسد. يظهر في طرف قصي مثقف يرفض تعريف نفسه بالانتماء لطائفته، يتحدث بعقلية نقدية، ويثني على الإيجابيات مما بدر من الحكومة الحالية، وعندما انتقد موقفا من السيدة عائشة الدبس انهالت عليه التعليقات والمباركة بعودته من صبوته من ثنائه السابق، وعندما بين موقفه المؤيد للحكومة بلغة نقدية وعلمية، وبعيدا عن النهج الموتور الذي يتبعه الآخرون عادوا إلى قطيعتهم.
مثقف آخر يرفض التعريف عن نفسه بانتمائه الطائفي، وأستاذ جامعي يتحدث عن الهوية العربية والإسلامية لسوريا رغم علمانيته، فتنهال عليه دعاوى التخوين للعلمانية وللطائفة التي ينسبونه لها. إن هؤلاء ليسوا رعاعا بل مثقفين سوريين يتصدرون وسائل الإعلام ومنابر كثيرة، وأثبتوا ظاهرة شعور عميم بالدونية تجاه الغرب وقيمه غثها وسمينها، كما وصفها أرنولد تونبي بمفهوم التحدي والمحاكاة، وتقليد المهزوم للقوي، وسعي لتقليد حداثة لا تنتمي لمجتمعاتنا، فأي انفتاح يشهده أولئك الذين عدوا أنفسهم نخبا وتعالوا على مجتمعاتهم مقارنة بما تعيشه امرأة في إدلب.
تلفزيون سوريا
———————
الحكومة السورية الجديدة بين التفرد والتحالفات المشبوهة والحلول الإبداعية/ مصطفى إبراهيم المصطفى
2025.02.14
كان السوريون فيما مضى يرددون عبارة: “الغرب يعمل لمصالحه”، وهذه عبارة فيها كثير من المغالطة، إذ هي تحصر العمل من أجل المصالح الخاصة بالدول الغربية فقط، علما أن العبارة لكي تستقيم يجب أن تكون: “إن الدول تعمل لمصالحها”، وهذا ما تطور في خطاب السوريين بعد أن أصبح لنظام بشار الأسد المخلوع مزيدا من الأعداء من خارج دائرة الدول الغربية. رغم ذلك، لم يعد التغيير في العبارة عن كونه تغيير باللفظ من دون المساس بالمضمون، بل يمكن القول إن المضمون أصبح أكثر إيذاء من ذي قبل، خصوصا إذا علمنا أن الغاية الأساسية من مثل هذه المعلومات هي جعل الإنسان منغلقا على ذاته ينظر إلى الآخرين نظرة ملؤها الشك والريبة. فالمصلحة في العقل الجمعي السوري تعني شيئا ذميما، أو ربما تعني أن الجهة أو الشخص الذي يعمل لمصالحه لا يستحق الشكر مهما كان عمله مفيدا لنا.
القشة التي قصمت ظهر البعير
بمنظور آخر، يعتقد بعضهم أن الهدف الرئيسي للآلة الدعائية للنظام البائد من تعميم فكرة العمل من أجل المصالح هو الأصدقاء قبل الأعداء، خاصة بعدما اضطر إلى الاستعانة بالروس والإيرانيين في حربه على الشعب الثائر ضده، ويبدو أن النظام البائد لم يكن يحاول غرس هذه القناعة في عقول السوريين وحسب، بل كان رأس النظام شخصيا يتبنى هذه القناعة، فهو في أحد تصريحاته المتأخرة أشار إلى أن روسيا وإيران تقاتلان في سوريا دفاعا عن نفسيهما. وفي نفس السياق كانت المستشارة الإعلامية في القصر الجمهوري للنظام المخلوع لونا الشبل قد صرحت ذات مرة موجهة كلامها للسوريين المؤيدين: لم يطلب أحد منكم القتال إلى جانب الدولة، أنتم قاتلتم دفاعا عن أنفسكم. وإلى أن جاء الوقت الذي انطلقت فيه عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الطغيان، يبدو أن هذا النفس الاستعلائي قد فعل فعله لدى الحلفاء ولدى جمهور المؤيدين معا، ويبدو أن هناك من أقسم أنه لن يطلق طلقة واحدة دفاعاً عن هذا النظام فيما لو تعرض للخطر مرة أخرى.
صناعة الأقلية
سقط نظام الطغيان غير مأسوف عليه وملأت الأفراح والاحتفالات فضاءات الوطن، وكان المحتفلون أغلبية ساحقة غمرت الساحات وهيمنت صورها وتعابيرها على الشاشات بمختلف أشكالها، وما أن بدأت الحكومة الجديدة تتلمس أولى خطواتها في إعادة تشكيل الدولة حتى بدأت الملاحظات وبعض الانتقادات تطفو على السطح، وعلى مستوى أروقة صناعة القرار، أو صناعة المواقف في مختلف مؤسسات المجتمع تواردت أنباء عن حديث خافت يلمح لبداية امتعاض يرتكز في معظم أطروحاته حول مقولة التهميش الذي بدأت تستشعره معظم القوى الثورية. لا شك أن الأصوات المتوجسة لم تصبح تيارا عريضا ينذر بالخطر، فكثيرون مازالوا يلتمسون الأعذار للحكومة الجديدة على مبدأ أن الفترة الحالية شديدة الحساسية، وهي مرحلة تحتاج لفريق متجانس يستطيع تنفيذ المهام المستعجلة بكفاءة أكبر. رغم ذلك؛ فالاستمرار بهذا النهج المتبع حتى الآن سيكون بمنزلة صناعة الأقلية التي لن تجد من يؤازرها عند الأزمات، أو هو بمنزلة القول للآخرين: كنتم تدافعون عن أنفسكم.
تحالف الفساد
لتلافي هذه المعضلة قد تجد الحكومة السورية الجديدة نفسها مضطرة إلى الانخراط في تحالفات مع بعض القوى الاجتماعية التي هي بالمحصلة قوى أنتجتها نظم شبه إقطاعية لا يمكن لها إلا أن تكون عائقا في طريق نمو المجتمع وتقدمه، وتكريسا لحالة الاستغلال والظلم الاجتماعي. إن ما يدفع للشك أو التوجس من اتخاذ الحكومة الجديدة لهذا المنحى هو القدر الهائل من القوة التي تمتلكه الزعامات القبلية والطائفية والدينية وأعيان المناطق، فهؤلاء يتبعهم قطعان كبيرة من الناس تقدس هذا النمط الثقافي – ربما – أكثر من الوجهاء أنفسهم، ولعل في هذا تفسير لماذا لا تتمكن كثير من الثورات السياسية في إنتاج تغيير يذكر، ولماذا هي تجد نفسها مضطرة إلى إعادة إنتاج النظام القديم مع تغييرات طفيفة في أحسن الأحوال. إن أقبح ما يمكن تصوره في هذا النوع من التحالفات أن المحسوبية والفساد قد فرضا نفسيهما كقوتين يصعب التغلب عليهما، وهو ما يتناقض مع التوجهات المعلنة للحكومة السورية الجديدة.
حلول إبداعية
إن تخفيض مستوى الفساد والمحسوبية للحد الأدنى وتطبيق مبدأ سيادة القانون الذي تنادي به الحكومة الجديدة قد يجرد الزعامات المجتمعية – بمختلف أشكالها – من كل مزاياها، وهذا ما سيجعل الحكم الجديدة في مواجهة مباشرة مع هؤلاء، بحيث لن ينفع أي نهج سياسي مهما كان منفتحا وتشاركيا. لذلك، يبدو أن الحكومة بحاجة لحلول إبداعية، فبالإضافة للحلول الكلاسيكية من تفعيل دور الرقابة وزيادة رواتب موظفي الدولة وتسخير التكنولوجيا، لا بد من إيجاد صيغة للتفاهم مع الزعامات المجتمعية من قبيل منحهم صفة الشريك في بناء دولة القانون مثلا. بمعنى إعطائهم ما يشبه الدور الرقابي على حسن تطبيق القوانين ومنحهم بعض الصلاحيات التي تجعلهم يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في بناء دولة القانون، فتحطيم البنى الثقافية للمجتمعات أصعب عشرات المرات من تحطيم الأنظمة السياسية، ولعل محاولة تعديل هذه البنى الثقافية بالتشارك مع الركائز الرئيسية لهذه البنى هو الأسلوب الأكثر جدوى وفاعلية.
أخيرا، وبالعودة إلى مقدمة هذا المقال، يجب أن يعلم جميع السوريين أن المصلحة هي المحرك الرئيسي للدول والجماعات والأفراد، والسوريون ليسوا استثناء. بمعنى أن الحديث عن المصالح يفترض البحث عن مدى تقاطع هذه المصالح ومدى تعارضها، فالمصالح تتقاطع أحيانا إلى حد التطابق أو ما يقارب ذلك، وتتقاطع أحيانا بمساحات تختلف، تكبر أو تصغر. وتتعارض المصالح أيضا بدرجات مختلفة قد تصل لمرحلة الصدام عندما يكون حجم التعارض كبيرا. وبالطبع، يترافق تقاطع المصالح مع نوع من التقارب والود والصداقة كسياق طبيعي للوضع الذي تخلقه هذه الحالة، ويترافق تنافر المصالح مع الفتور في العلاقات أو البغضاء والضغينة. بهذه الطريقة من التعاطي مع مفهوم المصلحة نتحول من مجتمع مغلق إلى مجتمع منفتح. وبالتالي مجتمع قابل للنهوض وعونا لأي حكومة تتطلع إلى التغيير.
تلفزيون سوريا
———————————
ثلاث أسئلة على بوابة سوريا الجديدة.. هل نسي السوريون بدايات ثورتهم؟/ بسام يوسف
2025.02.14
للأسف يمكن الإجابة بـ” نعم”، لكن ربما أرهقتهم سنواتها الطويلة المتخمة بالألم والقهر والدم فنسوا كيف بدأت، وربما دفعتهم فظاعة ووحشية ما فعله النظام السابق بهم فغاب عنهم لماذا قاموا بها، وأصبح همهم الوحيد هو أن يتخلصوا منه، غير آبهين كيف سيتخلصون منه، ومن سيخلفه، فالخلاص منه هو خلاص من الموت، وبعد ذلك يمكن أن ينظروا كيف سيتدبرون مستقبلهم؟!
تطابق قصة الشعب السوري وما حدث لحظة سقوط النظام الذي حكمهم بالحديد والنار، إلى حد كبير قصة السوريين الذين خرجوا من سجونه بعد أن غرقوا في العتمة واليأس والموت لسنوات، وفجأة حدث الزلزال فانفتحت الحياة أمامهم بكل اتساعها، وأصبح الضوء والحرية قبض اليد والعين، وكما يتصرف أي خارج من السجن، فيندفع بكل توق الحياة للابتعاد عن القبر الذي ابتلعه لسنوات، لا يهمه في البداية إلى أين يتجه، ولا من أخرجه من السجن، وشاغله الوحيد هو التمسك بالحياة التي امتلكها فجأة.
كما تصرف معتقلو سجن “صيدنايا” ومن السجون الأخرى للنظام البائد في ساعات حريتهم الأولى، تصرف السوريون الذين استيقظوا فجأة على هروب عائلة الأسد وعصابتها من سوريا، فسوريا على اتساعها لم تكن لتختلف كثيراً عن سجن “صيدنايا”، والسجّانون الذين أبدعوا في اختراع أشكال الموت في السجون، أبدع قادتهم في اختراع أشكال الموت خارجها، لكن وكما يستيقظ الخارجون من السجن بعد أن تهدأ فرحتهم بالحياة على سؤال القادم، وما العمل، يستيقظ السوريون الآن على السؤال الصعب الذي لابد من مواجهته: ماذا بعد؟، ورغم أنه سؤال ينفتح بداهة على المستقبل إلا أن الفاجعة تتجلى بأنهم يبحثون عن جوابه في الماضي، وفي إرث الماضي الثقيل، ويتناسون ما حلموا به وما رفعوا أصواتهم من أجله في أيام ثورتهم الأولى!
هل سوريا في خطر؟
هل أبالغ إن قلت إن سوريا لم تعرف خطراً في تاريخها أشد من الخطر الذي تعيشه اليوم؟! أعرف أن هذا سيكون صادماً، وسيعزز من تصنيفي ضمن المتشائمين، أو “المتصيدين في الماء العكر” كما يروق للبعض تسميتهم، لكن هل عرفت سوريا في تاريخها الحديث، أي بعد تشكّلها نهاية الدولة العثمانية مطلع القرن الماضي ظرفاً بالغ الضعف والهشاشة كما هي اليوم، دولة نصف مبانيها مدمرة، ونصف شعبها مهجر، واقتصادها منهار، وبلا جيش، وبلا أحزاب وقوى سياسية، والأخطر أنها في أشد لحظات انقسامها المجتمعي، والأدهى أنه انقسام ساخن ينفتح على الانتقام والثأر والحقد والدم.
في كل الدول التي عرفت ظروفاً مشابهة ونهضت من خرابها كان هناك عامل رئيسي في نهوضها، هو تصميم شعوبها على إعادة إعمارها ووحدتها والإخلاص لها، والأهم هو تبني أفرادها لهوية عليا جامعة، أما الدول التي غاب هذا العامل عنها فكان مصيرها إما التقسيم، أو التلاشي، بعد حروب طويلة، وبعد تغييرات ديمغرافية وتهجير سبقتها مجازر وفظائع.
الخطر الأكبر في سوريا ليس دمارها، ولا اقتصادها المنهار، ولا شعبها المهجّر، رغم خطورة كل هذا، الأخطر من هذا كله هو انقسامها المجتمعي الذي يزداد، وتفشي خطاب الكراهية، وانتشار الجرائم التي تُرتكب على أرضية الانقسام المجتمعي، والأمر الذي يزيد من خطورة هذا الانقسام، ومن تهديده لوحدة سوريا، هو أن السلطة التي تدير سوريا اليوم جزء فاعل فيه، وهي تسهم فيه متعمّدة، أو متواطئة، وبالتالي يغيب العامل الأهم في التصدي له أي السلطة الواعية المتنبهة لمخاطر هذا الانقسام، والدولة الجامعة التي ترى السوريين جميعاً على قدم المساواة.
هل هناك خطر على وحدة سوريا، وهل يمكن تقسيم سوريا؟
أيضاً لا أبالغ إن قلت أن هناك خطرا حقيقيا يهدد وحدة سوريا، ويدفع بها إلى التقسيم، وتتعزز كل يوم إمكانات هذا الاحتمال، سواء من الداخل السوري أو من خارجه، ولم يعد القول بأن الأطراف الدولية الفاعلة لا تريد التقسيم مقنعاً، سيما وأن المؤشرات التي تجري في المنطقة كلها بما فيها الداخل السوري، تعزّز منه، وأهم هذه المؤشرات هو ملامح ما يخطط له في هذه المنطقة، ومحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني داخل غزة والضفة، وإعادة رسم المنطقة جغرافياً، ولن تكون سوريا خارج هذه المعادلة، وما يعزز من حضور فكرة تقسيم سوريا، وتواطؤ أطراف داخلية وخارجية فاعلة، هو ما تعيشه سوريا اليوم من انهيار في ما تبقى من الدولة السورية، سواء عبر تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري، وعبر إبراز الهويات الفرعية، ومنع تشكل التمثيلات السياسية العابرة للطوائف والقوميات وكل التصنيفات الفرعية.
في هذا السياق يأتي الدفع لتشكيل المجلس العلوي، ويأتي اللون الواحد للسلطة التي تحكم سوريا اليوم، ويأتي تعقيد شروط التفاوض مع الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وكذلك الأمر في السويداء، رغم أن حل كل هذه التعقيدات ممكن لو أن هناك إرادة حقيقية لحلّه، فالإصرار على إضفاء صبغة واحدة على الدولة والسلطة في سوريا هو مقتل سوريا، ومن يستعيد تاريخ نشوء سوريا مطلع القرن الماضي، وكيف استطاع الآباء المؤسسون أن يتجاوزوا هذه المعضلة، يدرك مدى فداحة الخطأ الذي ترتكبه السلطة الحالية المتمثلة بالرئيس “أحمد الشرع”، والطاقم الذي يحيط به، والأطراف الخارجية الداعمة له.
لا يمكن تجاهل حقائق الأرض لو أردنا أن ننقذ سوريا، وإذا أردنا أن نشقّ الطريق إلى سوريا موحدة قابلة للحياة فإن أهم ما نحتاجه هو أولاً وقبل كل شيء هوية سورية جامعة، ترتكز على سلم أهلي حقيقي، جوهره العدالة والقانون والمساواة في المواطنة.
بعبارة شديدة الوضوح مهما تكن ردة الفعل عليها، أو استهجانها من قبل تيار واسع من السوريين، فإن سوريا ستبقى عرضة للتقسيم، وللاقتتال الأهلي مالم يتحقق فيها شرطان أساسيان:
أولاً: قادة سوريون يعلون سوريا فوق أي اعتبار آخر، يتصرفون كرجال دولة حقيقيين، يقرأون بعمق حقائق الجغرافيا والتاريخ، والتعقيدات الجيوسياسية لموقع سوريا وأهميته، ومصالح الدول الكبرى فيها.
ثانياً: دولة علمانية ديمقراطية، ترسّخ هوية سورية جامعة لكل السوريين، ولا تفيد في شيء تلك المخاتلة في تسمية الدولة “مدنية” أو “علمانية” فسوريا لا تقوم إلا عبر دولة علمانية في جوهرها، مهما تكن التسمية التي تطلق عليها.
————————-
نحن لسنا بيادق .. نحن الشعب الذي انتفض ضد النظام/ جوانا عزيز
تتناول هذه المقالة للكاتبة السورية سقوط نظام بشار الأسد، والظروف التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، وسنوات الحرب، والتحديات التي تنتظر الشعب السوري خلال المرحلة القادمة، مع إبقاء الاحتمالات مفتوحةً حقّاً لمستقبلٍ حرّ. جوانا هي ابنة عمر عزيز (أبو كامل)، المفكر الأناركي السوري، الذي كان وراء إنشاء المجالس الديمقراطية المحلية في دمشق أثناء الانتفاضة. عام 2012، اعتقلت قوات الأمن السورية عمر عزيز، واستُشهد في زنزانته عام 2013 وسط ظروف رهيبة.
مقدمة
أثناء جلوسي للكتابة، أستعيد في ذهني آخر مرة رأيت فيها والدي. كان واقفاً أمامي خلف قضبان حديدية، ضعيفاً ونحيفاً، ومع ذلك ابتسم لي. أحمل تلك الابتسامة في ذاكرتي. كنتُ أقف أنا وأمي على الجانب الآخر، وانضمت إلينا بقية العائلات التي كانت تزور أحباءها. المقصود من التفريق بيننا وبين السجناء كان واضحاً. لقد أخطأ السجناء في حق الدولة وعليهم أن يتحملوا عواقب تمرّدهم. أما نحن، في المقلب الآخر، فلم نتمرد على الدولة، لذا يمكننا أن نخرج من مبنى السجن طليقين والتجول بحرية.
اليوم، أجد نفسي، كما السوريون/ات في جميع أنحاء العالم، في خضمّ انهيارٍ من المشاعر، الفرح والحزن والأمل والخوف، كلٌّ منها يسحبني في اتجاه. كان سقوط النظام السوري حلمنا المشترك، وهو الهدف الذي طمحنا إليه، وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تحقق هذا الحلم/الهدف.
لفهم واقعة سقوط نظام الأسد، من المهم أولاً أن نفهم كيف صعد إلى السلطة. منذ استولى حافظ الأسد على السلطة في سوريا عام 1970، صمّم نظاماً للحكم بقبضةٍ من حديد على جميع المقيمين/ات على الأراضي السورية. خلال العقود الثلاثة الأولى، وضع حافظ نظاماً مبنياً على المحسوبية الرأسمالية والفساد المحميّ بالرقابة المكثفة، ودولة بوليسية عسكرية. أثبت هذا المزيج أنه فعّالٌ لإضعاف أيّة معارضة تقوم ضد عائلة الأسد.
تقوية الأساسات
استغل الأسد منصبه في السلطة لاحتكار السيطرة على جميع القطاعات الحيوية، فضمن للدولة السورية أن تهيمن تحت حكمه على كل قطاع تقريبًا من الحياة العامة والخاصة. وشمل ذلك الاتصالات والعقارات والتعليم والرعاية الصحية وحتى مؤسسات الزواج. وشهدت السبعينيات توسعاً كبيراً في القطاع العام، مما جعل الدولة صاحب العمل الرئيسي للسوريين/ات. وبحلول عام 2010، كان هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون سوري/ة على قائمة رواتب الدولة. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى طمس الخطوط الفاصلة بين عائلة الأسد والدولة السورية، ما جعل التمييز بينهما مستحيلاً تقريباً.
سوريا.. كيف نربط بين القضايا الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية لخدمة 99% من الشعب؟
10 شباط 2025
المحسوبية
ضمَنَ نظام الأسد الولاء له عبر تنمية شبكةٍ من النخب المرتبطة بالعائلة، وتقديم الحوافز الاقتصادية والاجتماعية لها. مُنِحت المناصب القيادية على أساس الولاء لعائلة الأسد، وغالباً ما كانت لأعضاء من طائفة الأسد ذاتها، أي الطائفة العلوية، إلى جانب حلفائه المقربين من طوائف أخرى. وقد ضمن هذا النظام القائم على المحسوبية ولاء شخصياتٍ رئيسية في القطاعات العسكرية والسياسية والتجارية لعائلة الأسد، مما عزز سلطة العائلة. وللتأكيد على هذه السلطة الشمولية، أقيمت تماثيل لا تعد ولا تحصى تكريما للأسد ومحسوبيه، ورمزاً إلى هيمنتهم الشاملة على سوريا.
العنف الجماعي والسجن الجماعي
ربما كان السلاح الأكثر فعالية في ترسانة الأسد هو استعداد نظامه لاستخدام العنف اللامحدود ضد شعبه. بلغت هذه الاستراتيجية ذروتها الأعنف مع مذبحة حماة عام 1982، أطلق نظام الأسد حينذاك حملةً عسكرية وحشية ردًا على انتفاضةٍ نظمها الإخوان المسلمين. وفي عام 2011، قتل النظام ما يقدر بنحو 10 آلاف إلى 40 ألف شخصاً ودمر أجزاء كبيرة من المدينة ذاتها. وقد أرسلت هذا الأحداث رسالة واضحة إلى بقيتنا: أي تحدٍ لحكم الأسد سيقابل بعنفٍ ساحقٍ وعشوائيّ.
وقد أدت الحرب السورية، التي بدأت في عام 2011 في عهد نجل حافظ، بشار الأسد، إلى تصعيد هذا العنف إلى نطاقٍ صناعي/تكنولوجيّ. استخدم النظام القصف الشامل والبراميل المتفجرة والهجمات الكيميائية لسحق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين. كما تم اعتقال عشرات الآلاف أو تعذيبهم/ن أو إخفائهم/ن.
ولا مكان يُوضح قدرة نظام الأسد على العنف أكثر مما تُظهره سجونه. من بين أكثر السجون شهرةً سجن تدمر و صيدنايا المعروف باسم “المسلخ البشري”.
تم تقسيم سجن صيدنايا إلى قسمين: “المبنى الأحمر” للتعذيب والإعدام، و”المبنى الأبيض”، الذي يضم السجناء المنتظرين لمصيرهم.
استناداً إلى شهادات من حراس سابقين، كشف تقريرٌ لمنظمة العفو الدولية في عام 2017، أنه: بعد الحرب السورية، تمّ تطهير المبنى الأبيض من سجنائه الحاليين إفساحاً لاستقبال المعتقلين/ات المتهمين/ات بالمشاركة في الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد. تشير التقديرات إلى أن حوالي 157.634 سورياً اعتقلوا بين مارس/آذار 2011 وأغسطس/آب 2024. من بينهم 5.274 طفلاً و10.221 امرأة. تحت المبنى الأبيض، تقبع “غرفة إعدام” يُنقَل المعتقلون/ات من المبنى الأحمر ليتم شنقهم/ن. في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 وحدها، تم شنق ما يقدر بنحو 13 ألف شخصاً هناك.
(يوم رأيتُ والدي عمر عزيز، وعندما خرجت من مبنى السجن، وقفت على أرض سوريا، مفترضةً أنني حرة. لكنني لم أشعر بأي طعمٍ للحرية)
وقد عرفنا منذ فترة طويلة عن أهوال هذه السجون. في أغسطس/آب 2013، قام منشقٌّ عسكري يُدعى قيصر، (كشف عن نفسه مؤخراً باسم فريد المذهان)، بتهريب 53275 صورة فوتوغرافية، وثقت وفاة ما لا يقل عن 6786 معتقلاً. قدمت هذه الصور لمحةً عن وحشية نظام الأسد. اليوم، وبعد تحرير هذه السجون والكشف عما كان بداخلها ،أصبحت الأمور أكثر وضوحاً.
تصف الروايات فظائع لا يمكن تصورها من الاغتصاب والتشويه وانتهاك الجثث والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والنوم والدواء. وقد استوحتْ سجون الأسد بعض أساليب التعذيب المعتمدة فيها من الممارسات الاستعمارية الفرنسية والألمانية، بما في ذلك الكرسي الألماني، حيث ينحني الضحايا إلى الخلف حتى ينكسر العمود الفقري. كذلك كان بساط الريح من أكثر اساليب التعذيب الرائجة داخل سجون الأسد، وهو لوحٌ خشبي مصمم لضم الركبتين والصدر معًا، يسبب آلاماً لا تطاق في الظهر. وأيضًا السلم، حيث يُربَط المعتقلون/ات إليه ويتمّ دفعهم/ن مراراً وتكراراً، ما يتسبب في كسر ظهورهم/ن مع كل سقوط. وأخيراً، كان المكبس الحديدي يستخدم للتخلص من الجثث بشكل جماعي.
من المفجع معرفةُ أن هذه الفظائع استمرت لسنوات. فالسوريون/ات اليوم إما ما زالوا يبحثون عن إجابات حول أحبائهم/ن المفقودين/ات، مثل وفا مصطفى التي لا تزال تبحث عن والدها، أو يحزنون على وفاة أفراد عائلاتهم/ن وأصدقائهم/ن المؤكدة. ففي هذا الأسبوع، نزل السوريون/ات إلى الشوارع حزناً على فقدان الناشط مازن الحمادة، الذي تأكدت وفاته في مستشفى عسكري. مازن، رمز المقاومة واللطف، له مكانٌ أبدي في قلوبنا إلى جانب عددٍ لا يحصى من آخرين كرسوا/ن حياتهم/ن من أجل حريتنا اليوم: رزان زيتونة، وسميرة خليل، وغياث مطر، وكل الرجال والنساء والأطفال الشجعان الذين ضحوا/ضحيّن من أجل مستقبل سوريا.
في تحقيقٍ حديث، يكشف فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أدلّةٍ تشير إلى أن النظام متواطئ في حرق الجثث على نطاق صناعي. “أين الجثث؟” يسأل. منذ يوم أمس، تم اكتشاف حوالي 50 كيساً من بقايا بشرية في أرضٍ قاحلة بالقرب من دمشق، وهي واحدة من العديد من المقابر الجماعية المشتبه بها. وتأكيداً لدعوة عبد الغني، أؤكد على الحاجة الملحة لمعرفة مكان دفن الجثث، حتى يتمكن/تتمكن السوريون/ات من دفن أفراد أسرهم/ن والبدء في رسم مستقبلهم/ن.
ومع ذلك، وسط كل هذا الظلام، هناك فرحٌ وعزيمة. لقد أظهرت مقاطع الفيديو الأخيرة إطلاق سراح سجناء، من بينهم/ن أطفال صغار، ورجال بالغون فقدوا ذاكرتهم بسبب الظروف المروعة داخل السجون، ونساء ولدن في الأسر أطفالاً من آباء لا يعرفنهم. وعلى رغم هذه المعطيات المؤلمة، فإن اليوم هو يوم أمل، حيث تجتمع العائلات، ويحتضن/تحتضن الأحباء/الحبيبات المنفصلون/ات منذ فترة طويلة بعضهم/ن بعضاً مرة أخرى. إن تفكيك سجن صيدنايا حدثٌ مهمٌّ يجب تذكره.
نحن نقف في أول أيام سقوط نظام الأسد، حيث تم إسقاط التماثيل، وتحطيم الصور، وتشتيت المحسوبيات، وتبديد المخابرات. عائلة جمعت الثروة وأوقعت 90٪ من الشعب السوري في الفقر، تجد الآن منزلها مفتوحاً، حيث يمشي الناس العاديون ويأخذون ما يحلو لهم. هي مفارقة حلوة، أو ربما انتقام مناسب.
لكن احتفالنا سيكون قصيراً.
ماذا بعد؟
إن الفراغ الذي تركه النظام تستغلّه فصائل قومية مثل هيئة تحرير الشام – وهي منظمة استبدادية ذات أيديولوجية أصولية إسلامية، والجيش الوطني السوري – وهو وكيل لتركيا. ويُنظَر إلى كل من هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري على أنهما يشكلان تهديداً لسوريا ديمقراطية. وعلى رغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحرضا على العملية العسكرية التي أدت إلى سقوط النظام، فإن إسرائيل تعارض تحرير سوريا بسبب المخاطر المحتملة التي يمكن أن تشكلها سوريا محررة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.
من الضروري في هذه اللحظة أن نرفض كل أشكال القومية العربية والكيانات الاستعمارية المتجذرة في التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني، سواءٌ أكانت مدفوعة من قِبَل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو تركيا أو غيرها من البلدان. يجب علينا أيضاً حماية وضمان عدم المحو الممنهج للمجموعات العرقية بما في ذلك الآشوريين والكورد والنوبيين والأرمن.
الأمر متروكٌ الآن للسوريين/ات لتفكيك الأساسات الهرمية وإعادة بناء الديمقراطية من خلال “السلطة من الأسفل”. إن نضال والدي ورفاقه يثبت قدرة الطبقة العاملة على الحكم الذاتي من خلال المجالس المحلية. لقد تمكنوا حينها من الازدهار من دون الدولة، من خلال تنظيم التعليم والمستشفيات والخدمات، يُسيّرها أناس عاديّون. ومنذ سقوط النظام، قام السوريون/ات بالفعل باستعادة المهام الأساسية التي أهملها النظام. والمبادرات لتنظيف واستعادة الأماكن العامة مثالٌ يشهد على ذلك.
من المؤسف أن العالم يقف مرةً أخرى مكتوف الأيدي، متردداً في تقديم الدعم الذي نستحقه. اليوم، كما في الماضي، يسعى الخطاب إلى الحد من إمكانيات التغيير في سوريا. نحن نُصَوَّر كأشخاص سلبيين/ات، وتشوَّه سمعتنا بنظريات المؤامرة، ونُوصَم باعتبارنا بيادق في لعبة جيوسياسية كبرى.
ولكننا لسنا بيادق. نحن الناس الذين ثرنا ضد نظام كنا نعلم أنه سيقتلنا.
يوم رأيتُ والدي، وعندما خرجت من مبنى السجن، وقفت على أرض سوريا، مفترضةً أنني حرة. لكنني لم أشعر بأي طعمٍ للحرية. كان الشعور بالمراقبة والخوف هما المألوفان، فقبضة النظام في كل مكان، في الشوارع، في المحلات التجارية، على الطرق، وفي عيون الناس. رأيتُ سوريا كلها وكأنها سجن ضخم.
إذا كان هناك رسالةٌ أريد مشاركتها مع العالم، فهي هذه: ما لم تتمكن أنتَ/تِ ومجتمعك من تحديد أسلوب حياتك، فأنتَ/تِ تعيش/ين داخل سجن كبير. سجن يسعى إلى السيطرة على إمكاناتنا وخيالنا وتقييدها. إذا أمكن لواحدٍ من أكثر الأنظمة دكتاتوريةً ووحشية في القرن الحادي والعشرين أن ينهار في غضون أيام، فإن النظام الرأسمالي الذي يهيمن على حياتنا ويستغلها قد ينهار أيضاً. يجب أن نكون قادرين على الحلم بهذا العالم الحر، كما حلم والدي بسوريا الحرة.
ترجمة : انطوني برمانا
كاتبة سوريّة، تتركّز كتاباتها حول المقاومة والحركات الشعبية وقضايا السجناء السياسيين، مستلهمة من والدها الراحل عمر عزيز، أحد الشخصيات البارزة في انتفاضة سوريا. تتعمق جوانا في رحلة سوريا خلال الحرب السورية وأيّ مستقبلٍ ينتظر شعبها.
(نشرت هذه المقالة منذ بضعة أسابيع على موقع Black Rose Anarchist باللغة الانكليزية. وهي تعبّر عن وجهة نظر الكاتبة فقط)
حكاية ما انحكت
————————
كيف شكّلت الأغاني “ساحة معركة” في “سوريا الأسد”؟/ هند الشيخ علي
الجمعة 14 فبراير 2025
منتصف عام 2007، كنت أتنقّل بين محافظتَي دمشق وريف دمشق المختلفتَين طابعاً وشكلاً، كما اختلفت غالبية المناطق في سوريا آنذاك، من حيث طقوس الاحتفال بـ”المرشح الرئاسي الوحيد”، “المختار عن قناعة ورضا” تامّين، بشار الأسد. كان عمري 11 عاماً فقط، ولكنني كما غيري من الأطفال في مثل هذه السنّ، كانت لديّ بعض الأسئلة الفضولية: “بمن نحتفل؟ ولماذا؟”، إلّا أنّ السؤال الأهم كان: “ماذا نغنّي؟”.
مشاهد الخيام التي كانت تُنصب لأيام في الحارات والأحياء والساحات وعلى الأرصفة في المحافظات السورية كافة خلال انتخابات 2007، لا تُنسى. من تلك الأيام التي كانت فيها السياسة تُرتَّب على إيقاع معيّن، أستطيع أن أسترجع أصوات الناس وأذكر كيف كانت الأغاني تملأ الأجواء، وتمجّد بشار الأسد، الحاضر وجهه في عشرات الصور المرفوعة، مع الدعاء له بالتوفيق والنصر في معركة انقلبت عليهم.
كان الناس يرقصون ويتمايلون ويدبكون على ألحان أشبه بالطقوس الجماعية، ويردّدون الكلمات نفسها، ويحيون فوزاً لم يكن فوزهم، بل كان فوز سلطة لا تسمح حتّى بالمنافسة. لم تكن الأغاني حينها مجرّد ألحان، كانت شعارات تُغنّى بصوت عالٍ، وتعيد تشكيل الواقع كجزء من مشهد أكبر.
اعتمد نظام حافظ الأسد، على الأغاني والأناشيد، كجزء أساسي من الدعاية الرسمية لتعزيز الولاء للحزب الحاكم -حزب البعث العربي الاشتراكي- والقائد، واستُخدِمَت هذه الأغاني في المدارس، والإذاعة والتلفزيون والمهرجانات الوطنية والمناسبات السياسية والعسكرية، لتصبح من الأدوات الرئيسية لتعزيز حكم الأسد الأب، ما جعلها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للسوريين لعقود، وترتبط على نحو مؤسف اليوم بحالة “نوستالجيا” غير مفهومة لديهم.
وفي عهد الأسد الأب، كانت الأغاني والأناشيد ترمي إلى تصوير القائد ضمن إطار لا يمكن المساس به، وتعزيز دور “البعث” كحزب مسيطر يُعزى إليه كل نجاح محقّق في الدولة، فضلاً عن إحاطة الجماهير بأجواء الولاء المطلق، التي يمكن من خلالها خلق هوية سياسية منحازة تربط بين حب الوطن وشخص الحاكم، لا الدولة نفسها أو الشعب. حتّى النشيد الوطني في البلاد، أعاده نظام حافظ الأسد، بعد وصوله إلى السلطة عام 1971 عقب فترة من وقفه إبّان فترة الوحدة بين مصر وسوريا، ووظّفه في سياقات تخدم الدعاية الرسمية، وأصبح منذ ذلك الحين نشيد الجيش البعثي، لا جيش الشعب، وأداةً لتمجيد الأسد عبر ربط صورته بالدولة والجيش، وهو ما عزّز فكرة أنّ الولاء للأسد، هو ولاء للوطن نفسه. وعادةً ما كانت اللقطات المصاحبة للنشيد خلال بثّه على التلفزيون، تُظهر حافظ الأسد، أو الجيش في استعراضات الولاء، ما خلق ربطاً نفسياً بين الجيش والنظام الحاكم.
وقد استمرّ هذا النهج خلال عهد الأسد الابن، إلا أنّه مع اندلاع الثورة السورية وانقسام الشارع السوري، لم تعد أغنية السلطة وحدها تهيمن على المشهد، خاصةً أنه عندما خرجت المظاهرات الأولى في درعا ودمشق وحمص، كانت الأغاني والأهازيج وسيلة التعبير الأساسية عند المتظاهرين. وبدأ الناشطون لاحقاً، مع توسّع الحراك، بتأليف أغانٍ تحمل رسائل مباشرةً بإسقاط النظام، ومع تحوّل الثورة إلى صراع مسلّح، وتصاعد العنف، لم تعد الأغاني الوطنية مقتصرةً على جانبَي الولاء للسلطة أو الاحتجاجات ضدها، بل أصبحت تنقل واقع المدن المحاصرة والمجازر واللجوء وتوثّق المعاناة، لعلّها تصل عبر الأغاني إلى الخارج، وتحرّك المجتمع الدولي إزاء انتهاكات نظام الأسد، وجرائمه.
حتّى مع دخول الجماعات الجهادية المتشدّدة إلى دائرة الصراع في سوريا، مثل داعش وجبهة النصرة، استخدمت هذه الجماعات الأناشيد كأداة للتجنيد وبثّ أفكارها التي تركّز على الجهاد العالمي والقتال، ليس من منطلق وطني فحسب، بل أيضاً من منطلق ديني. واعتمدت عليها بشكل أساسي في شنّ حرب نفسية ضد الخصوم، سواء عبر إظهار القوة أو التهديد المباشر.
بالمثل، استخدمت الجماعات الشيعية الأناشيد أيضاً، كأداة لتأطير معركتها في سوريا، وتبريرها بأنّها “دفاع عن المقدّسات”، ولكن مع امتداد النفوذ الشيعي في البلاد خلال سنوات الحرب، بدأت هذه الأغاني والأناشيد تتحوّل إلى أداة للترويج للهوية الشيعية العابرة للحدود، وما يسمّى بـ”أيديولوجيا المقاومة”.
في هذا التقرير، يستعرض رصيف22، أبرز هذه الأغاني والأناشيد تبعاً للسياق الذي جاءت فيه خلال الحرب السورية، وأطراف الصراع التي عبّرت عنها.
أغاني الثورة… صوت المتظاهرين
لعلّ أكثر الأغاني التي اشتهرت في بدايات الثورة، هي تلك التي ارتبطت بالشعارات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، وقد أصبحت جزءاً من هوية الحراك الشعبي، وفي مقدمتها أغنية “يلا ارحل يا بشار”، التي قيل إنّ مؤلفها هو شابّ سوري من مدينة حماة، اسمه “إبراهيم القاشوش” عُرف بقيادته المظاهرات التي هتفت بإسقاط النظام ونيل الحرية آنذاك، كما نُسبت إليه معظم الشعارات والألحان التي ردّدها المتظاهرون ضد حكم الأسد. ورُوي عن مصير القاشوش، أنّ قوات النظام اعتقلته في 2011، بعد قيادته حشود “جمعة ارحل” في ساحة العاصي، واقتلعت حنجرته وألقته في نهر العاصي.
مصير عبد الباسط الساروت، منشد الثورة السورية وأحد أبرز رموزها، لم يختلف كثيراً عن مصير القاشوش، إذ لقي حتفه في 2019، خلال معارك ريف حماة، واشتهرت بصوته مجموعة من الأغاني والأناشيد الثورية، أبرزها “جنّة جنّة يا وطننا”، التي أعيدت صياغتها لتناسب السياق السوري، و”طيّب إذا منرجع”، التي غنّاها المتظاهرون في حمص عام 2012. هذه الأغاني وغيرها أعاد الفنان السوري وصفي المعصراني، تأديتها، وقد اشتهرت بصوته أيضاً أغانٍ أخرى للثورة السورية منها “ع الهودلاك”، و”درعا تنادي هبّوا يا أحرار” التي كانت من أوائل الأغاني التي غنّاها المعصراني للثورة، وأيضاً “حمص يا دار السلام”. ومن الجدير ذكره أنّ المعصراني تعاون مع الساروت، في إعادة إنتاج “جنّة جنّة يا وطننا”، وغيرها.
ومن الأغنيات التي اشتهرت في بداية الثورة أيضاً، “يا حيف”، للفنان السوري سميح شقير، والتي تُعدّ من أكثر الأغاني الوطنية المؤثرة خلال الحرب السورية، حيث وثّق فيها شقير، ما جرى في درعا من اعتقال للأطفال وإطلاق نار على المتظاهرين السلميين، ولكن كان أكثر ما جاء فيها من عبارات مؤثرة هي تلك التي حملت تعابير عتاب ولوم واستنكار للطريقة التي تعاطى بها النظام مع المتظاهرين دون أن يفرّق بين كبير وصغير، متسائلاً: كيف يمكن للسوري ابن البلد أن يقتل إخوته أبناء البلد؟ ومن أجل ماذا؟
ولم يكن الفنانون والناشطون السوريون هم فقط من غنّوا من أجل الثورة السورية. ثمة فنانون عرب قاموا بذلك أيضاً، إلّا أنّ أغنياتهم لم تحقق الانتشار الذي حققته الأغاني التي انطلقت من الساحات في سوريا خلال الاحتجاجات، ولا حتّى تلك التي أنتِجَت لاحقاً في إستوديوهات خارج البلاد، نذكر منها أغنية “صرخة… رسالة طفل لاجئ”، للمنشد المغربي رشيد غلام. تصوّر هذه الأغنية معاناة الطفل السوري في مخيمات النزوح خلال فصل الشتاء. وهذه الأغنية هي شكل من أشكال تطوّر الأغنية المرتبطة بالصراع السوري، وانتقالها إلى مرحلة رواية القصص عن حياة السوريين التي شكّلتها الحرب، وقذفت بهم إلى مصائر مجهولة وبائسة.
أغاني الموالاة… “الأسد قبل البلد”
وبينما ركّزت أغاني الثورة على مفاهيم الوطن والحريات والأخوّة وتغنّت بالمدن السورية، كانت الأغاني الموالية للأسد، تركّز على شخص بشار الأسد نفسه، وتُظهره على أنه القائد الضروري لاستقرار البلاد وأمنها وسلامها. معظم هذه الأغنيات، تضمّنت بوضوح عبارات الولاء المطلق للرئيس، بل تعدّى بعضها هذا الحدّ، إلى درجة تفضيل الأسد على الأرض والشعب والروح الإنسانية، مثل “منحترق بنار، ومنموت كبار ما منقبل يحكم سوريا إلا بشار”. وعلى غرارها، ظهرت أغانٍ اتّخذت طابع الأغنية الشعبية في بعض المرات، لتمجّد الأسد وتسخر من هزيمة أعدائه في معركتهم الهادفة إلى إسقاطه، وتؤكد على اصطفاف الشعب وراء قائده في مواجهة المؤامرة المعادية، مثل “ودّوا للعالم برقية… بو حافظ قائد سوريا”.
سقطت مفردة الوطن من سياقات تلك الأغنيات، كأنّها تعبير صريح عن أنّ الحرب السورية، وكل ما آلت إليه من موت ومعاناة وتشرّد وجوع، لم تكن من أجل الوطن، ولا دفاعاً عنه، بل من أجل بشار الأسد وحده. هذه الأغنيات كانت جزءاً من الآلية التي اتّبعها نظام الأسد، في إسكات المعارضة في أولى سنوات الحرب، وأسلوب السلطة الأنجع في مخاطبة المجتمع الدولي الذي يراقب وينصت لـ”إرادة الشعب”، فهذه أغنيات تؤكد أنّ خيار الشعب هو الأسد، وهذه ساحات تغنّي له تلك الأغنيات، وهذه جموع ترفع صوره في الساحات، وترقص على إيقاعات “ملايين ملايين السوريين”، و”منحبك”، و”متل الشمس جبينك عالي”، و”نحن رجالك بشار”.
حتّى جيش النظام، لم تكن له حصة وافرة من الأغنيات الوطنية التي نظّمها الطرف الموالي للحكم. قلّة قليلة من الأغاني تطرّقت إلى الجيش، أو تحدثت عنه، وبالمثل، لم تكن هناك أغانٍ محسوبة على هذا الطرف تقصد الوطن وحده، باستثناء أغنية الفنان السوري ناصيف زيتون، “طير الحرية”، التي حققت شهرةً واسعةً منذ صدورها خلال سنوات الحرب الأولى، وحتّى بعد سقوط النظام، وغنّتها جميع الأطراف. وما جعل هذه الأغنية محسوبةً على الطرف الموالي للنظام، هو أنّ الإعلام الرسمي لم يكن ممنوعاً عن بثّها، كما أنّ المسيّرات المؤيدة كثيراً ما غنّتها، ولعلّ هذه الأغنية هي الخروج الوحيد عن النمط الذي ساد أغنيات الموالاة، وطغى على حناجر الجماهير في ساحات النظام للتأكيد على خيارها وقرارها آنذاك.
أناشيد الجهاديين والشيعة… التعبئة والحرب النفسية
في عام 2005، أرسل أيمن الظواهري، أحد مؤسسي تنظيم القاعدة، رسالةًً إلى “أبو مصعب الزرقاوي”، قال فيها: “نحن في معركة، ونصف هذه المعركة يدور في الإعلام”. ولعلّ إدراك قادة التنظيم لأهمية نصف المعركة هذا، جعلهم يفكرون أكثر في كيفية استثمار الأنشودة الجهادية لجذب الشباب وحتّى الأطفال، وتحطيم الخصوم نفسياً، لتصبح جزءاً من حملة التنظيم للترويج للسلفية الجهادية، حيث استخدمها بشكل أساسي كخلفية للّقطات والمشاهد التي توثّق تفاصيل حياة المجاهدين، وتبثّ الحماسة في نفوس المتلقّين من خلال إظهار مشاهد الاقتحام والتدريب واستعراض الأسلحة والسيوف، وحتّى قطع الرؤوس، وأشهر تلك الأناشيد “صليل الصوارم”، التي ذاع صيتها في سياق الحرب السورية كثيراً.
ومن المفارقة، أنّ تلك الأناشيد التي يرى البعض أنّها “سبب رئيس من أسباب التحاق 90% من الشباب بالمجاميع الجهادية”، تلقّفتها مجموعات أخرى داخل سوريا بطريقة مختلفة تماماً، فرقص أفرادها وغنّوا على أنغامها، نساءً ورجالاً، ووضعوها في سياقات ساخرة وخالية تماماً من الجدّية المخيفة التي توحي بها.
انتشر “نمط القاعدة” خلال الحرب في سوريا على حساب الأناشيد الدمشقية التي نشأ عليها معظم أبناء التيار الملتزم في البلاد، وفضّلته الجهات المموّلة لهذا النوع من الأعمال، لما له من قوة وتأثير كبيرين في سياق رسالة الجهاد، فالقول السائد هنا كان: “قوة المجاهد في معاركه بعد عقيدته هي الأناشيد”. ولعلّ هذا القول هو نفسه الذي يحكم الأنشودة الشيعية، أو ما يُعرف بـ “اللطمية”، حيث اشتهر عدد كبير من اللطميات في سوريا خلال سنوات الحرب، وفي بعض المرات جاءت في خضمّ حرب إعلامية شرسة بين تنظيم الدولة “داعش” وإيران، حيث لجأت الأخيرة مثلاً إلى إنتاج مقاطع فيديو مصحوبة بأناشيد تهدد مقاتلي داعش بقطع رؤوسهم، وبناء القلاع من جماجمهم، بعد أن هاجمها التنظيم بالمثل.
عموماً، استُخدمت الأناشيد في جزء كبير منها، خلال الحرب في سوريا، كحرب ناعمة بين السنّة والشيعة على وجه التحديد، في دلالة واضحة على التفسّخات الطائفية في البلاد، ودخول لاعبين أساسيين بأيديولوجيات مختلفة إلى الحرب، لكلّ منهم أهدافه العقائدية بعيداً عن مفاهيم الوطن والأرض والحريات أو النضال ضد الأنظمة الديكتاتورية، وبعيداً عن تلك الشعارات التي خرجت من أجلها حشود المتظاهرين أول سنوات الحرب، ودفعت من أجلها الكثير.
فمثلاً لو تتبّعنا كلمات أشهر تلك الأناشيد والأغنيات، لما وجدنا -إلا في ما ندر- أيّ ذكر للوطن، أو لشهداء الثورة أبناء الوطن، ولما وجدنا أي تعبير بأيّ طريقة من الطرائق عن تطلعات الشعب السوري إلى مستقبل أفضل ينالون فيه من الحرية والأمان شيئاً.
وإذا كنّا لا نذكر من تلك الأناشيد أمثلةً كما استعرضنا سلفاً، فهذا لكونها تتضمن عبارات ذات إيحاءات تحرّض على القتل بدافع طائفي وعقائدي يحجب معظمها موقع “يوتيوب”، ونكتفي أن نضعها في سياق استخدامها خلال الحرب السورية، لنبيّن كيف تساهم هذه الأناشيد في فهم تطورات الحرب في سوريا وأبعادها وأطرافها، بعد أن قدِمت -أي الأناشيد- من أفغانستان، وتطورت في الشيشان أيام السوفيات، ووصلت إلى بلاد الشام، لتجابه بموسيقى أو من دون موسيقى، اللطمية، بعد دخول حزب الله والجماعات المسلحة المدعومة من إيران إلى دائرة الصراع.
ماذا عن أغاني المرحلة الحالية؟
قبل ساعات قليلة من إسقاط نظام الأسد، اكتفى العاملون في التلفزيون السوري ببثّ الأغاني الوطنية “الحيادية” على شاشته، بعد أن تنبّؤوا بأنّ “الخبر” الرسمي، الذي كان منحازاً لجهة النظام الساقط، لم يعد له مكان. ومع دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى مبنى التلفزيون، وسيطرتهم على البثّ، بدأ هؤلاء بإذاعة ابتهالات وأناشيد جهادية وسلفية دوناً عن أي شيء آخر، في الوقت الذي كانت فيه الساحات تغنّي وترقص، دون لحن يحرّكها سوى شعارات رُتّبت كيفما اتّفق عن الحرية والخلاص.
——————————
ملاحظات
Fares Albahra
سعة انتشار التهجم المنهجي على السلطة القائمة، والتشكك بها وبنواياها “على الطالعة والنازلة” كما يقال، والعودة مراراً وتكراراً إلى التهمة الأولى على طريقة المحققين الأسديين، يشير إلى ثقة عالية في أن سلوكاً كهذا لن يعود على ممارسيه بأي ضرر شخصي أو عائلي، مما يضع هذا الموقف العدائي والمتناقض جوهرياً نفسه في محرق الشك: فأية فائدة له؟ عدا عن شعور ممارسيه أن بإمكانهم استهلاك هذا الصنف من البضائع السياسية الشعبوية الذي حرموا منه طويلاً.
ما من شك أن سمة هذه المرحلة المؤقتة هي الديكتاتورية، إذ يجري الاعتماد فيها على الموثوقين في هرم السلطة حصرياً، وتوخي أن يكون الانفتاح على غيرهم تدريجياً وبخطوات متمهلة ومحسوبة. وليس الأمر سراً.
فأي معنى يحمله النحيب على الديمقراطية ورثاء الحريات في الشهور الأولى من انتقال سلطة وفي مرحلة ينعدم فيها أي شكل من أشكال المؤسسات الديمقراطية ولا يمكن ضبط الفوضى فيها إلا باستبداد بالسلطة سيترافق حتماً بمساوئ الاستبداد المعروفة؟
مواجهة الأخطاء ورفضها ضرورة لا شك فيها بالتأكيد، لكن الموقف البارانوئيدي المستند مع ذلك على اطمئنان شديد بعدم وجود عواقب تصدر عن من يجري وسمهم بأنهم مجرمون وارهابيون، يبدو بادي التناقض وغير مقنع.
وتبدو معه مسرحية الاحتجاج الدائمة كوميديا مبتذلة، تذكر بحزب أسس في روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي، كان أعضاؤه يطالبون بتخفيض حرارة غليان الماء ورفع درجة التجمد…
الفيس بوك
————————–
ملاحظات. برهان غليون
عن بعض الأولويات والواجبات
لا أدري اذا كان تشكيل لجنة لمؤتمر الحوار الوطني ستساعد على اقناع الدول الغربية بتخفيف العقوبات الكارثية على المجتمع السوري او أن تخفف من شكاوى الفئات السياسية والاجتماعية التي تشعر بالغبن لاستبعادها من المشاركة بعد زوال نظام الطغيان.
لكن مهما كان الحال في هذه المسألة، اعتقد ان الأولوية القصوى في المحافظة على السلم الأهلي وتطمين الجمهور الشعبي الواسع والمتنوع، كان ولا يزال إلى الآن، تشكيل هيئة العدالة التي تنتظر، من دون صفات اضافية، عملها للبدء بمحاكمة المتهمين والمطلوبين وتطمين المواطنين العاديين الذين لا تلحقهم اي تهمة، مهما كانت اصولهم وعقائدهم ومنطاقهم، على حقوقهم الأساسية. وأرى ان النظر الى هذه المسألة قد تأخر كثيرا من دون سبب واضح. وتأخره يضر بعودة الوئام الاجتماعي والوطني وبصورة النظام الذي استمد شرعيته الأساسية من إنهاء حكم عائلة الاسد وشبيحتها أي من رفعه الظلم الكبير والعام وتحقيق العدالة الأساسية للشعب السوري برمته.
وفي السياق ذاته، اعتقد ان الأولوية الأساسية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي هي انشاء هيئة لرعاية الفئات الاجتماعية ذات الأحوال الهشة التي لا تملك ادنى مقومات الحياة، والتي زاد الانتقال، وما رافقه من توقف الأعمال واتساع نطاق البطالة والتسريحات الوظيفية، من هشاشتها بل من جوعها وبؤسها، بينما لا يتوقف الحديث في الاوساط السياسية والاقتصادية عن الترحيب المطلوب بأصحاب الأموال والمشاريع الاقتصادية الموعودة .
الفيس بوك
————————————————-
أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا.. بين دعم القوى الإقليمية والدولية واعتراضات المعارضة..!/ د. عبدالرحيم جاموس
في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، برز السيد أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، كزعيم للمرحلة الانتقالية في سوريا. هذا التطور قد أثار تساؤلات حول المنطق السياسي وراء اختياره وتسويقه عربياً وإقليمياً ودولياً، وما دور القوى الإقليمية والدولية في تنصيبه، بالإضافة إلى مواقف بقية أطراف المعارضة السورية تجاهه.
إن المنطق السياسي وراء تسويق أحمد الشرع كرئيس مؤقت لسوريا يستند إلى عدة عوامل منها:
القدرة على توحيد الفصائل المسلحة: بعد سقوط نظام الأسد، كانت هناك حاجة ماسة لقيادة تستطيع توحيد الفصائل المسلحة المختلفة تحت مظلة واحدة. الشرع، بصفته قائدًا سابقًا لهيئة تحرير الشام، تمكن من دمج العديد من الفصائل في الجيش السوري الجديد، مما يعزز الاستقرار الأمني في البلاد.
البراغماتية والواقعية السياسية: على الرغم من خلفيته الإسلامية المتشددة، قد أظهر الشرع مرونة سياسية من خلال الانخراط في الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، مما أدى إلى إزالة المكافأة المالية التي كانت مرصودة لاعتقاله من قبل الولايات المتحدة. هذا التحول يشير إلى استعداده للتكيف مع المتطلبات الدولية والإقليمية والعربية.
الحاجة إلى ملء الفراغ السياسي: بعد انهيار النظام السابق، كان هناك فراغ سياسي كبير. جاء تولي الشرع للرئاسة المؤقتة كخطوة لملء هذا الفراغ والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار الكامل.
أدوار القوى الإقليمية والدولية في تنصيب أحمد الشرع
الدعم الخليجي: زيارة الشرع إلى المملكة العربية السعودية ولقاؤه مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان أشارت إلى دعم عربي خليجي للقيادة الجديدة في سوريا. هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا والحد من النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة.
الموقف الغربي والدولي: على الرغم من تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية سابقًا، أبدت بعض الدول الغربية استعدادًا للتعامل مع الرئيس الشرع نظرًا لتحوله البراغماتي وسعيه لإعادة بناء سوريا الجديدة. هذا الانفتاح الغربي والدولي يهدف إلى دعم الاستقرار والأمن في سوريا ومنع عودة الجماعات المتطرفة لتصدر المشهد فيها.
إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية: جاء دعم الشرع في سياق سعي بعض الدول الإقليمية لإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة، خاصة مع تراجع نفوذ إيران في سوريا ولبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مواقف المعارضة السورية
تباينت ردود فعل المعارضة تجاه تنصيب أحمد الشرع:
المعارضة في المنفى: دعت شخصياتها، مثل هادي البحرة من الائتلاف الوطني السوري، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطياف السياسية. كما طالبوا بصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.
القوى الكردية: تم استبعاد القوات الكردية من المحادثات الدستورية، مما أثار استياءها. هذا الاستبعاد قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
الفصائل المسلحة: بينما انضمت بعض الفصائل إلى الجيش السوري الجديد تحت قيادة الشرع، لا تزال هناك فصائل أخرى متحفظة أو معارضة لقيادته، خاصة تلك التي تختلف أيديولوجيًا مع هيئة تحرير الشام.
التحديات التي تواجه أحمد الشرع
بناء الشرعية: على الرغم من الدعم الإقليمي والدولي، يحتاج الشرع إلى بناء شرعية داخلية من خلال تحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية.
إعادة الإعمار: تتطلب إعادة بناء سوريا موارد هائلة وتعاونًا دوليًا. رفع العقوبات عن سوريا والحصول على دعم مالي سيكونان عنصرين أساسيين في هذا السياق.
التعامل مع التحديات الأمنية: لا تزال هناك جيوب للمقاومة والتطرف في بعض المناطق السورية، مما يتطلب استراتيجية أمنية فعالة وشاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
إن تسويق السيد أحمد الشرع كرئيس مؤقت لسوريا جاء نتيجة لمزيج من الضرورات الداخلية والتوازنات والتفاهمات الإقليمية والدولية. إن قدرته على التكيف والبراغماتية والواقعية السياسية، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي، قد تسهم في تحقيق الاستقرار في سوريا. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على مدى قدرته على بناء توافق وطني داخلي شامل، دون إقصاء لأي من مكونات الشعب السوري، والتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
————————————
=========================




