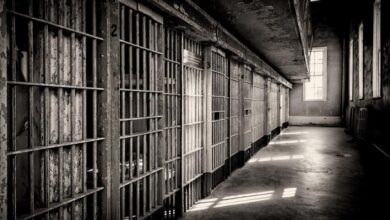الصورة الورقية والصورة الرقمية… من تخليد اللحظة إلى تبديدها/ عبد السلام بنعبد العالي

16 فبراير 2025
مسيرة تحول من الذاتي إلى المعلوماتي
فروق كثيرة تميز الصورة الورقية عن الرقمية. أولها أن الفرق بين الصورتين هو الفرق ذاته بين الكيمياء والرياضيات. تسمى الصورة الورقية الصورة التناظرية. تعني كلمة “تناظر” Analogie “تشابها” أو “تماثلا”. الكيمياء لديها علاقة مشابهة بالضوء، إذ تحفظ الأشعة المنبعثة من موضوع الصورة في حبيبات صغيرة من الفضة. لكن لا وجود لأي تشابه أو تناظر بين الضوء والأرقام. الوسيط الرقمي يترجم الضوء إلى بيانات، وفي هذه العملية، يضيع الضوء. في التصوير الرقمي، تحل الرياضيات محل الكيمياء.
تنقل الصورة الورقية أو التناظرية إلى الورق، عبر السلبي، آثار الضوء المنبعثة من الموضوع المصور. إنها، في جوهرها، صورة من الضوء. في مختبر الغرفة المظلمة، يعاد الكشف عن الضوء، مما يجعلها، بالتالي، “غرفة مضيئة”. أما الوسيط الرقمي، فعلى العكس من ذلك، يحول الأشعة الضوئية إلى بيانات، أي إلى نسب رقمية. البيانات ليست مضيئة ولا مظلمة، بل تقطع استمرارية ضوء الحياة. يلغي الوسيط الرقمي العلاقة السحرية التي تربط الشيء بالصورة الفوتوغرافية عبر الضوء.
هشاشة
غالبا ما نحافظ على الصورة الورقية بالعناية التي نوليها لشيء عزيز على قلوبنا. هشاشتها المادية تجعلها عرضة للشيخوخة والانحلال، إنها تولد فتواجه الفناء. لا عجب إذن أن نلاحظ أن دراما الفناء والبعث تهيمن على نظرية التصوير الفوتوغرافي في كتاب “الغرفة المضيئة” لرولان بارت، تلك النظرية التي يمكن قراءتها كمديح للصورة التناظرية. فباعتبار هذه الصورة شيئا هشا، تكتب لها نهاية حتمية بالفناء، لكنها في الوقت نفسه وسيط للبعث. من المفارقات الأساسية للصورة الورقية هي أنها تنتج الموت عندما تحاول أن تحفظ الحياة و”تخلدها”. عندما تسعى الصورة لأن تجعل الغياب حاضرا، فإنها تغدو بذلك شهادة حقيقية على غياب هذا الحضور.
يستعمل بارت اللفظ اللاتيني spectrum للدلالة على هدف الصورة و”موضوعها”. وهو يستعير هذه الكلمة من الفزيائي إسحق نيوتن الذي كان أطلقها دلالة على الطيف الضوئي، أي على سلسلة الألوان التي ينحل إليها الضوء الأبيض. الكلمة آتية من الفعل specere الذي يعني الرؤية، وهو يعادل اللفظ الإغريقي الذي يدل على الشبح والطيف. موضوع الصورة يرتبط إذن بالرؤية والفرجة والاشتباه، لكنه يرتبط أساسا بالموت والأشباح وحضور الغياب و”عودة الأموات”.
كتاب “الغرفة المضيئة” لرولان بارت
عندما تلتقط الصورة الضوئية المنبعثة مما تمثله وتثبتها على حبيبات صغيرة من الفضة فإنها لا تعيد فقط إحياء ذكرى الموتى، بل تجعل من الممكن اختبار حضورهم، بإعادتهم إلى الحياة من جديد. تجسد الصورة التناظرية الزوال، حتى على مستوى المرجع. فالشيء المصور يبتعد بلا رجعة في الماضي. تحمل الصورة الفوتوغرافية طابع الفقدان والحداد. إنها “طيف”، و”إشعاع” سحري “للموضوع”، وكيمياء غامضة للخلود: يخلد الجسد المحبوب من خلال وساطة معدن ثمين هو الفضة، ويمكن أن نضيف إلى ذلك فكرة أن هذا المعدن، مثل جميع المعادن في علم الكيمياء القديمة، “معدن حي”. كتب بارت: “تولد الصورة الورقية مثل كائن حي، مباشرة من حبيبات الفضة التي تنبت، وتزدهر للحظة، ثم تشيخ. يهاجمها الضوء والرطوبة، فتبهت، تضعف، ثم تختفي”. التصوير الفوتوغرافي هو الحبل السري الذي يربط الجسد المحبوب بالمشاهد متجاوزا الفناء. إنه يساعده على البعث من جديد، ويحرره من الموت الذي سقط ضحيته. و”هكذا، فإن للصورة الفوتوغرافية علاقة ما بيوم القيامة”.
حداد مفرط
يرتكز كتاب “الغرفة المضيئة” على عمل حداد مفرط. يستحضر بارت فيه والدته الراحلة بإلحاح. وعن صورة فوتوغرافية لوالدته – غير مضمنة في الكتاب – (حيث يبرز غيابها بوضوح)، يكتب: “وهكذا، فإن صورة فوتوغرافية حديقة الشتاء، رغم شحوبها، هي بالنسبة إليّ كنز الأشعة التي انبعثت من أمي حين كانت طفلة – من شعرها، من بشرتها، من فستانها، من نظرتها في ذلك اليوم”.
تهدف الصورة إلى أن تخلد اللحظة، وتلتقط ما ينبض حياة، تهدف إلى أن تشهد على ما مضى، إلا أنها تعجز مع ذلك أن تخلق تاريخا وتنسج ذاكرة. وهذه مفارقة أخرى من مفارقات الصورة الفوتوغرافية تضاف إلى جمعها بين الحياة والموت، الحضور والغياب. نعلم أن الصورة من مواليد منتصف القرن التاسع عشر، اللحظة التي عرفت ميلاد علم التاريخ. لكن بينما يسعى الخطاب التاريخي لاستعادة الاحداث وضبطها وربما ربطها بغيرها، فإن الصورة الفوتوغرافية على حد قول بارت “لا تستعيد الماضي ولا تخلده… إن وقعها عليّ لا يمثل في استعادة ما زال وامحى، وإنما في الشهادة على أن ما أراه، قد تم وحصل… التاريخ ذاكرة ننسجها وفق مناهج وضعية، إنه خطاب عقلاني يقوم على أنقاض الزمان الأسطوري، أما الصورة الفوتوغرافية فمن المؤكد أنها شهادة، إلا أنها شهادة هاربة منفلتة”.
استلاب الصورة
يجعل بارت استلاب الصورة مكونا من مكوناتها قبل أن تدخل في مسلسل الإنتاج الإعلامي، فيعترف أنه كل مرة كانت تؤخذ له صورة، كان يراوده إحساس بالزيف و”اللا أصالة”. فالصورة تمثل في نظره “تلك اللحظة التي لا أعود فيها لا ذاتا ولا موضوعا، وإنما ذاتا تشعر أنها غدت موضوعا، إنها إذن لحظة أعيش فيها تجربة موت صغرى: فأنا أغدو فيها شبحا بالفعل”.
لذا قلنا إن الصورة تشير أساسا إلى غياب وضياع وانفلات. في هذا الصدد تردد سوزان سونتاغ بعد والتر بنيامين: “بدأت الصور الفوتوغرافية تعطي صورة عن العالم في اللحظة التي غدا فيها الوضع البشري يعاني من ارتفاع ايقاع الهزات الكبرى، ففي اللحظة التي بدأنا نرى فيها عددا هائلا من أشكال الحياة البيولوجية والاجتماعية يتعرض للتلف في وقت وجيز، في هاته اللحظة بالضبط أصبح في إمكاننا تثبيت صورة ما ينفلت ويختفي”.
فكأنما كان اللجوء الى الصورة لجعل النوع البشري يواجه عجزا كبيرا وهو كونه لم يعد قادرا أن يعيش الديمومة لا وجدانيا ولا رمزيا. لذا فإن عصر الصورة هو أيضا عصر الثورات والاحتجاجات والاغتيالات والتفجيرات، أو على حد قول بارت “عهد نفاد الصبر”، عهد افتعال الديمومة لمقاومة الانفلات و”تثبيت” ما يسارع الخطى.
غلاف فارغ
إذا كان الإقرار بأن “هذا قد تم وحصل” هو حقيقة التصوير الفوتوغرافي، فإن التصوير الرقمي مقارنة بذلك، ليس سوى غلاف فارغ. فالصورة الرقمية تستبعد ما تنقله. فليس لها صلة مكثفة، حميمة، بالموضوع المصور. إنها لا تغوص فيه، لا تخاطبه، ولا تدخل معه في حوار، لا تقوم على لقاء فريد، خاص، لا رجعة فيه مع الموضوع. حتى الرؤية التي تصدر عن حامل الكاميرا في الصورة الفوتوغرافية نفسها تفوض هنا إلى الجهاز. إن إمكان المعالجة الرقمية يضعف العلاقة مع الموضوع المصور، ويمنع الانغماس في الواقع. وبانفصالها عما تمثله، تصبح الصورة الرقمية مرجعية ذاتها. إنها تنتج واقعا جديدا، واقعا لا وجود فعلي له، واقعا يفوق الواقع، واقعا سورياليا Sur-réel.
إذا كان الغموض والحميمية والتستر هي ما يميز الصورة الورقية، فإن الصورة الرقمية تعيش على “العراء” والوضوح والذيوع و”التقاسم”. التصوير الفوتوغرافي التناظري ينطوي على حكايات وأسرار، فباعتباره وسيطا للذكرى، فإنه يروي حكاية ومصيرا. إنه محاط بأفق سردي: “التاريخ جزء من الصورة لأنه يدفع إلى التأمل في الحياة، في الموت، في الانقراض الحتمي للأجيال”. لذا فإن هذه الصورة لا تتقاسم إلا في إطار حميمي، وهي تظل تحفظ أسرار الأقرباء. أما الصورة الرقمية فلا تلتقط للاحتفاظ بها. وهي لا تشكل وسيطا للذكرى، ولا تتم طباعتها وحفظها. إنها، مثل أي معلومة، ترتبط بالآني. التصوير الرقمي، لا يصنع سردا روائيا، بل هو مجرد لقطات متفرقة. يولد الهاتف الذكي نوعا جديدا من التصوير، يتمتع بزمانية مختلفة تمام الاختلاف عن زمانية التصوير على الورق، وصوره تظل بلا عمق زمني، بلا امتداد روائي، بلا مصير ولا ذاكرة، مجرد صورة للحظة العابرة.
رغم هذه الفروق كلها، فقد نجد نقاط التقاء بين الصورتين الورقية والرقمية، ربما تكمن في وضعهما الأنطولوجي: إذا كانت الصورة الرقمية تطرد الموضوع المنقول لتحوله إلى معلومة، أفلا ينطبق هذا أيضا على نظيرتها الورقية التي “تطرد” هي كذلك موضوعاتها كي لا تحتفظ منها إلا بـ”صور”.
المجلة