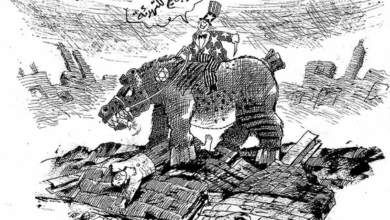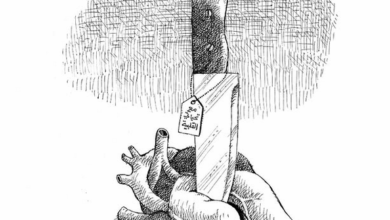سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 18 شباط 2025
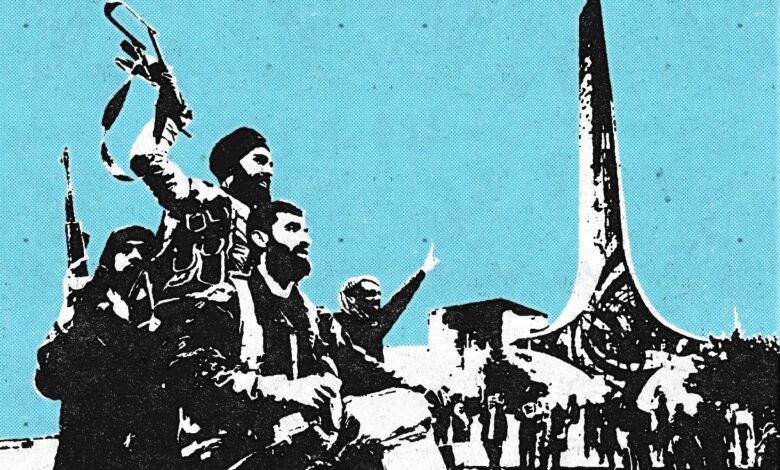
حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————————
إعادة بناء سورية من الثورة إلى التجديد/ أحمد داود أوغلو
18 فبراير 2025
مضى شهران على سقوط نظام بشّار الأسد الذي اشتُهر بجرائمه ضد الإنسانية. وبعد المعاناة والتضحيات الهائلة، حان الوقت للانتقال من المرحلة الاحتفالية للثورة السورية إلى مرحلة إعادة البناء الاستراتيجي، أي بناء سورية الجديدة منارة للسلام والاستقرار في المنطقة. وفي حين أن الثورات بطبيعتها تمثل تحدّياً، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في معالجة قضايا ما بعد الثورة وبناء نظام عادل ومستقرّ لشعب دفع ثمناً باهظاً من أجل الحرية.
وبصفتي صديقاً ومؤيداً لسورية منذ زمن طويل، حيث تابعت من كثبٍ تطوّراتها عقوداً، فإنني أقدّم رؤيتي وتوصياتي للإدارة الجديدة بقيادة السيد أحمد الشرع، وكذلك للقادة الإقليميين والدوليين، إذ إن نجاح سورية في الانتقال من حالة الثورة إلى تشكيل إطار سياسي مستقرّ لن يؤمّن مستقبلها فحسب، بل سيجلب الاستقرار للمنطقة بأسرها. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدّي الفشل في القيام بذلك إلى الفوضى والتدخل الأجنبي والحروب بالوكالة وصعود الإرهاب.
وتتطلب إعادة بناء سورية إلى تناول سبع ركائز أساسية لبناء نظام وطني جديد. الانسجام الثقافي والسياسي: المواءمة بين المواطنة والهوية الوطنية. إعادة التأهيل الاجتماعي: معالجة الصدمة العامة والأضرار وإعادة إدماج اللاجئين. الأسس الجيوسياسية: الموازنة بين الجغرافيا والأمن والاستقرار الوطني. التنمية الاقتصادية: معالجة الإنتاج والتوظيف والحد من الفقر. الشرعية الدستورية: ضمان الحرية والأمن والعدالة. التماسك المؤسّسي: بناء القوة الهيكلية والتنظيمية. التكامل العالمي والإقليمي: تعزيز العلاقات والفعالية الدولية.
يمثل كل عنصر من هذه العناصر تحدّياً واضحاً لإعادة بناء سورية دولة قومية. في الواقع، تواجه اليوم كل دول الشرق الأوسط تقريباً تحدّيات مماثلة بصفتها منطقة مجزّأة بسبب خريطة “سايكس بيكو” التي رسمتها القوى الاستعمارية البريطانية والفرنسية عام 1916، والتي تمزّقت أكثر بسبب إنشاء إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وانقسمت خلال الحرب الباردة، واهتزّت بسبب الربيع العربي.
الانسجام الثقافي والسياسي: المواءمة بين المواطنة والهوية الوطنية
يتمثل أحد التحدّيات الرئيسية في بناء مجتمع متماسك وشامل في الفترة الانتقالية في المواءمة بين الهويات الثقافية والسياسية المتنوعة تحت إطار موحّد للمواطنة. وتتطلّب هذه العملية الاعتراف بالطبيعة التعدّدية للمجتمع واحترامها مع تعزيز الشعور المشترك بالانتماء والهوية الجماعية المتجذرة في الحقوق والمسؤوليات المتساوية.
ولتحقيق ذلك، من الضروري إنشاء آلياتٍ تحمي التنوّع الثقافي والتعدّدية السياسية مع تعزيز الحوار والمصالحة بين مختلف الطوائف. وينبغي أن تؤكّد السياسات مبادئ المساواة وعدم التمييز والشمولية، بما يضمن عدم شعور أي مجموعةٍ بالتهميش أو الإقصاء من الهوية الوطنية. ويجب أن تشمل عملية المواءمة أيضاً إصلاح الأطر القانونية والمؤسّسية لتعكس قيم المواطنة بدلاً من التقسيمات الطائفية أو العرقية. ويمكن أن يلعب التعليم والإعلام ومبادرات المجتمع المدني دوراً محورياً في غرس ثقافة الوحدة والاحترام المتبادل، وإرساء أسس لمستقبلٍ مستقرٍّ وديمقراطي.
هناك حقيقة تاريخية واضحة يجب أن يعترف بها كل من يحاول إقامة نظام سياسي في المنطقة أو الحفاظ عليه: إن منطقة الشرق الأوسط هي إحدى المناطق التي ينعكس فيها التنوع الثقافي للبشرية بشكل عميق على مسرح التاريخ. ولا يمكن للدول غير القادرة على المواءمة بين الهويات الثقافية والسياسية أن تحافظ على وجودها مهما كانت قوتها العسكرية. فانهيار كل من نظام البعث/ صدام في العراق، ونظام البعث/ الأسد في سورية نابعٌ، في المقام الأول، من اعتمادهما على التضامن الطائفي داخل الأيديولوجيا البعثية، الأمر الذي أعاق تطوير حسّ المواطنة المشتركة.
القضية الأكثر إلحاحاً وأساسية في سورية اليوم هي الشروع الفوري في عملية مصالحة وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز الشعور المشترك بالهوية. ولا يمكن تضميد الجراح التي سبّبتها ديكتاتورية نظام “البعث” الذي كان يمثل أقلية في نظام البعث الدكتاتوري، ومعالجة الآثار السلبية للتحوّلات الديمغرافية الناجمة عن النزوح الداخلي والخارجي خلال الحرب الأهلية، وتمكين السكّان من العودة إلى مناطقهم، إلا من خلال جهد مصالحة وطنية شاملة.
ويجب استخلاص الدروس المستفادة من النماذج السياسية الإثنية الطائفية التي شهدها لبنان والعراق، ولا سيما من الانقسامات الإثنية السياسية وعواقبها في عراق ما بعد صدّام حسين. ومع ذلك، يجب ألّا يكون البديل عن ديكتاتورية الأقليات هيمنة الأغلبية أو الهياكل السياسية القائمة على الفصل العرقي أو الطائفي.
ومن شأن تشكيل مجلس مصالحة وطنية واسع وشامل وتشاركي، قادر على تمثيل جميع الطوائف العرقية والطائفية والدينية في سورية (مثل العرب والأكراد والتركمان والسنة والعلويين والدروز والمسيحيين) أن يقلل من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، ويضمن السلم المجتمعي. وخلال هذه العملية، يجب عدم إقصاء السوريين العلويين أو إخضاعهم لإجراءات انتقامية بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. إن مبادرات مثل جمع قادة من مختلف الجماعات الدينية لجهود المصالحة المحلية، كما حدث في اللاذقية في الأيام الأولى للإدارة الجديدة، لها أهمية حاسمة في تجاوز هذه الفترة الحساسة.
علاوة على ذلك، من شأن مشاركة الطائفة الدرزية في السويداء التي دعمت الثورة، وممثلي المسيحيين في جميع أنحاء سورية في جهود المصالحة الوطنية أن يعزّز الثقة الاجتماعية. كما أن من شأن دمج الأكراد والتركمان في شمال سورية في النظام وضمان الدمج الكامل للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة الجديدة باعتبارها مكونات متكاملة أن يتصدى لمحاولات تقسيم سورية.
إعادة التأهيل الاجتماعي: معالجة الصدمة العامة والأضرار وإعادة إدماج اللاجئين
من أكثر العناصر أهمية وإلحاحاً في العملية الانتقالية ضمان العودة إلى ظروف معيشية طبيعية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان الذين عانوا صدمات نفسية واجتماعية عميقة خلال أكثر من نصف قرن من حكم الأسد و13 عاماً من الحرب الأهلية. ويجب إيلاء اهتمام خاص لإعادة تأهيل النساء الأرامل اللواتي فقدن أحباءهن والأطفال اليتامى والسجناء الذين أمضوا سنوات في المعتقلات، فضلاً عن إعادة توطين اللاجئين الذين أُجبروا على ترك منازلهم. ولهذه الغاية، ينبغي إنشاء “مؤسّسة إعادة التأهيل البشري وإعادة التوطين”. ويمكن تمويل هذه المؤسّسة من خلال التعويضات التي يتم جمعها من ثروات أفراد النظام، بما فيهم عائلتا الأسد ومخلوف، اللتان تتحمّلان مسؤولية إلحاق هذه المشاق بالشعب السوري.
وفي هذا السياق، سيكون تيسير عودة اللاجئين السريعة مع تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة عاملاً رئيسياً في بناء الثقة في الإدارة الجديدة في الفترة الانتقالية. كما ينبغي إعلان بطلان جميع القرارات التي اتّخذها النظام السابق، والتي انتهكت الحقوق القانونية الشخصية وحقوق الملكية للّاجئين الذين أجبروا على مغادرة بلدهم أو مدنهم، مع تمكين اللاجئين من العودة إلى مساكنهم الأصلية وتقديم الدعم الخاص عند الضرورة لضمان إعادة إدماجهم، بما في ذلك إعادة توظيفهم في وظائفهم السابقة.
المكون الجغرافي للنظام الوطني: الأسس الجيوسياسية والأمن
عندما أقوم بتحليل استراتيجية دولة ما، غالباً ما أضع نفسي مكان صانع سياسات تلك الدولة، وأتساءل: “ما الذي أوصي به إذا كنت سأقوم بصياغة عمق استراتيجي لهذا البلد”؟. من خلال هذا المنظور، تشكّل السمات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية والجغرافية الثقافية لسورية هيكلية استراتيجية أقرب إلى عمود فقري وجناحين.
العمود الفقري لهذا الإطار هو المحور الشمالي- الجنوبي، الذي يمثله ممرّ حلب- حماة- حمص-دمشق- درعا. وتشكل المنطقة الساحلية الشامية الجناح الأول الذي يربط سورية بشرق المتوسّط، بينما تشكّل المنطقة الواقعة شرق الفرات جناح بلاد ما بين النهرين. وتحظى السيطرة على العمود الفقري بين الشمال والجنوب بأهمية بالغة، لأنها تؤثّر بشكل مباشر على الحكم في سورية. وقد كان سقوط إدلب وحلب إيذاناً بتآكل هذا العمود الفقري الاستراتيجي، الأمر الذي ساهم، في نهاية المطاف، في انهيار نظام الأسد.
ومع ذلك، إذا بقي جناحا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين منفصلين سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً عن العمود الفقري، فإن سورية تخاطر بفقدان منفذها البحري إلى الغرب، وتعريض وحدة أراضيها في الشرق للخطر. يجب مقاومة الجهود الرامية إلى تفتيت سورية، على غرار استراتيجية “فرّق تسد” التي نفذتها القوى الاستعمارية الفرنسية على شكل مناطق حكم ذاتي، سنّية وعلوية ودرزية، بالنظر إلى عودة الأطماع الاستعمارية الجديدة بشكل مختلف، ولا سيما التي تتمحور حول أمن إسرائيل.
هذا الإطار الجيوسياسي حاسم لأمن سورية الداخلي وعلاقاتها في المنطقة. وعندما يندمج هذا الإطار في نظام سياسي متماسك، يمكن أن يحوّل سورية إلى قوة إقليمية كبرى. ورغم ذاك، إذا أسيء التعامل معه، يمكن أن تصبح سورية مصدراً للصراع الداخلي والتوترات الإقليمية.
وتتمثل الأولوية الفورية في توحيد العمود الفقري والأجنحة تحت هيكل أمني واحد داخل الجيش الوطني السوري، من خلال دمج جميع الفصائل من خلال برامج فعّالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. ويجب أولاً تنظيم مجموعات المعارضة من مختلف المدن إلى جانب العسكريين الموالين لها في قوة منسقة، ثم إضفاء الطابع الرسمي عليها في نهاية المطاف ضمن تسلسل هرمي عسكري. وهذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة العامة وحماية وحدة سورية وسلامة أراضيها. علاوة على ذلك، من الضروري أن تقطع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، وتندمج في هذا الإطار الأمني المركزي، فالتحدّي المتمثل في توحيد جهاز أمني وطني في بيئة ما بعد الصراع، حيث تهيمن الفصائل المليشياوية موثق بوضوح في تجربتي لبنان والعراق.
وبعيداً عن الأمن الداخلي، هذه البنية الجيوسياسية محورية في علاقات سورية الإقليمية، فالعمود الفقري الشمالي- الجنوبي يربط سورية بأوروبا والبحر الأسود عبر تركيا، ويمتد أيضاً إلى شبه الجزيرة العربية والخليج عبر الأردن. وفي الوقت نفسه، تشترك مع تركيا والعراق في عمق بلاد ما بين النهرين، وتشترك مع تركيا ولبنان وفلسطين والأردن في عمق شرق المتوسط – المشرق العربي عبر تركيا ولبنان وفلسطين والأردن ثم مصر.
في عام 2010 قبل اندلاع الحرب الداخلية، كان هدفنا الأساسي في تركيا إطلاق مبادرات مثل الحوض الاقتصادي لبلاد الشام (تركيا- سورية- لبنان- الأردن) واتحاد بلاد ما بين النهرين (تركيا- سورية- العراق). كانت هذه المشاريع تهدف إلى استعادة الأحواض الطبيعية التي عطّلتها اتفاقية سايكس بيكو، وإعادة بناء علاقات اقتصادية وثقافية سلمية عبر المناطق التي قسمتها القوى الاستعمارية بشكل مصطنع.
التنمية الاقتصادية: معالجة قضايا الإنتاج والتوظيف والحد من الفقر
في ظل الظروف الاقتصادية المتردّية التي تمرّ بها سورية، يطالب الشعب السوري بإلحاح بالحصول على الضروريات الأساسية، مثل المأوى والغذاء، من الإدارة الجديدة. ومع ذلك، وبعيداً عن جهود الإغاثة الفورية، يحتاج الاقتصاد إلى استراتيجية إصلاح طويلة الأجل للتعافي. يجب أن تركز المرحلة الأولى من إعادة التأهيل الاقتصادي على: إطلاق التعبئة الاقتصادية لمكافحة الانهيار والفقر من عهد “البعث”. استعادة الأصول التي نهبتها عائلتا الأسد ومخلوف. التقدّم بطلب إلى الأمم المتحدة والدول المعنية لرفع الحظر المفروض على سورية. تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة وإيجاد فرص استثمارية. إنشاء صندوق بمساهمات دولية، خاصة من البنك الإسلامي للتنمية، لإعادة بناء البنية التحتية المنهارة في البلاد. إعطاء الأولوية لإحياء الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة.
من شأن إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية طارئة وواضحة أن تولّد دعماً شعبياً، وتضع الأساس للسلم الاجتماعي. وترتبط التنمية المستدامة للاقتصاد السوري على المدى الطويل ارتباطاً مباشراً بالخصائص الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية المذكورة سابقاً، فالعناصر الرئيسية التي توفر لسورية مزايا تنافسية نسبية، ويمكن أن تضخ الحيوية في اقتصادها، ترتبط ارتباطاً جوهرياً بموقعها الاستراتيجي والجغرافي الاقتصادي . موقع سورية الاستراتيجي مزايا كبيرة للنمو الاقتصادي المستدام. ويمكن للعناصر الرئيسية التالية أن تنعش الاقتصاد:
– الممرّ اللوجستي الاقتصادي: تقع سورية على طول الممر اللوجستي الأمثل الذي يربط شبه الجزيرة العربية والخليج بالبحر الأبيض المتوسط عبر الطرق البرّية، وعبر تركيا، إلى أوروبا. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية للطرق السريعة والسكك الحديدية، ستسمح بالوصول إلى أوروبا من الخليج عن طريق عبور أربعة حدود وطنية فقط. وحقيقة أن معظم هذا الممرّ يتكون من أراضٍ مستوية، ما يقلل من تكاليف النقل ويوفر ميزة كبيرة.
– مركز عبور الطاقة: يسمح موقع سورية بأن تكون بمثابة طريق عبور رئيسي لموارد الطاقة الإقليمية.
– الإمكانات الزراعية: تقع سورية في منطقة الهلال الخصيب، وتتمتّع بفرصة إجراء إصلاحات زراعية متقدّمة، مع التركيز على إنتاج الأغذية العضوية، وهو ما يدعم أيضاً توفير فرص عمل للّاجئين العائدين.
– النمو الصناعي: يمكن للمناطق الصناعية الصغيرة والمتوسّطة الحجم على طول الممرّات الرئيسية في سورية أن تعزّز فرص العمل في المناطق الحضرية.
– السياحة: يوفر تاريخ سورية الغني وتراثها الثقافي الثريّ، والذي يضم مدناً، مثل دمشق وتدمر وحلب، إمكانات كبيرة للسياحة الدينية والثقافية، وهي مصدر دخل قيّم.
ولا يتطلب تحقيق هذه الإمكانات إصلاحات اقتصادية فحسب، بل يتطلب أيضاً إصلاحاً شاملاً لأنظمة الأمن والتعليم والرعاية الصحية.
الشرعية الدستورية: ضمان الحرية والأمن والعدالة
يؤسّس الفكر الإسلامي التقليدي شرعية النظام السياسي على حماية الحياة والفكر والعقيدة والنسب والملكية، وهي مبادئ سبقت حقوق الإنسان الحديثة، ولا تزال تدعّم القانون الدولي اليوم. وتتمثل المهمّة الأساسية للحكومة الانتقالية في ضمان هذه الحقوق.
ويكمن في صميم الشرعية السياسية التوازن بين الحرية والأمن، فالدولة تحقق الشرعية عندما تحقق أقصى قدر من الأمن، من دون تقييد الحرّيات الفردية وتضمن الحرية من دون المساس بالأمن. تؤدّي التضحية بالحرية من أجل الأمن إلى الاستبداد، في حين أن إعطاء الأولوية للحرية على الأمن يمكن أن يؤدّي إلى الفوضى. ومن ثم، تتوقف شرعية الدولة على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.
تنبع النزاعات والحروب الأهلية في الشرق الأوسط، إلى حد كبير، من الفشل في إقامة نظام دستوري يضمن الحرية والأمن في آن. وقد ترك هذا الفراغ المنطقة محاصرة بين الديكتاتوريات القمعية وفوضى الإرهاب. ولقد أدى تركيز بشار الأسد، في سورية، على أمن الدولة إلى القضاء على الحرّيات، ما أدّى، في نهاية المطاف، إلى إشعال الحرب الداخلية، وتمكين الجماعات الإرهابية من تأجيج مزيدٍ من الفوضى. ويجسّد تدمير بنية الدولة السورية والمجتمعات المتنوعة في سورية هذه الحلقة المفرغة من الديكتاتورية والعنف. وعلى الإدارة الجديدة كسر هذه الحلقة. ويكمن المفتاح في تبني رؤية لتعددية ثقافية تدمج حقوق الإنسان الأساسية بالتراث الثقافي المتنوع في المنطقة.
وبعد أن مضى شهران على إظهار الحماس الثوري، يجب أن يتحوّل الاهتمام الآن إلى عملية انتقالية استراتيجية. مما يوجب على الحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها في الشهر المقبل (مارس/ آذار)، أن تركز على استعادة النظام العام وإرساء الأمن وضمان قيام نظام دستوري. وكما أوصى أحمد الشرع، قد يكون من الضروري وضع جدول زمني للانتخابات مدّته أربع سنوات، ولكن يجب أن تركز هذه الفترة أيضاً على تفعيل النظام العام المدني، وإعادة تفعيل النظام القضائي، وتعزيز المصالحة الوطنية، وصياغة دستور جديد.
وقد يؤدّي تأخير استعادة النظام العام، ولو يوماً، إلى توترات داخلية، وربما يمهد الطريق لنظام ديكتاتوري آخر. يجب ألا ننسى الدروس المستفادة من انقلابات الستينيات التي أدّت إلى صعود حافظ الأسد. ولتنفيذ النظام العام المدني، يجب أن تتحوّل قوات المعارضة إلى هياكل نظامية للشرطة والجيش. كما يجب إعادة تفعيل الحكومة المركزية بطابع مدني، ويجب أن تتولّى اللجان المحلية زمام المبادرة في الحكم. وستكون هذه الجهود مدعومة ببيروقراطية غير ملوثة محورية لنجاح العملية الانتقالية.
يجب أن تضمن العملية القضائية محاكماتٍ عادلة للمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وتجنّب الانتقام أو العقاب الجماعي، فالقمع الذي يبقى من دون عقاب، يؤدّي إلى زعزعة ثقة الشعب، بينما ستؤدي الممارسات الظالمة، مثل القتل خارج نطاق القضاء إلى تفتيت الشعب.
في سياق المصالحة الوطنية وصياغة الدستور، إنشاء “هيئة استشارية” مؤلفة من قادة الرأي الذين رفعوا أصواتهم ضد القمع البعثي، وشاركوا في تنظيم المعارضة، وساهموا في الثورة السورية، ويمتلكون القدرة على تمثيل مختلف الفئات المجتمعية، سيساهم، بشكل كبير، في سير العملية بسلاسة وحل الأزمات المحتملة. وفي إطار هذه الهيئة الاستشارية، ينبغي تشكيل لجنة تضم خبراء في القانون الدستوري وممثلين عن الفئات الاجتماعية، للبدء بعملية صياغة دستورية تشاركية. ويجب أن تستند هذه العملية إلى مبادئ “وحدة الأراضي السورية” و”حقوق الإنسان الأساسية” و”التمثيل العادل”.
إجراء عملية دستورية شاملة وهادئة أمر ضروري لاستقرار سورية على المدى الطويل وإقامة نظام وطني دائم.
التماسك المؤسّسي: بناء القوة الهيكلية والتنظيمية
من الضروري ضمان الأداء الفعال والإصلاح الشامل في نهاية المطاف لمؤسّسات الدولة، ولا سيما الوزارات والهيئات القضائية والمؤسسات الاقتصادية مثل البنك المركزي، وإصلاحها بشكل شامل. إعادة التنظيم المهني للبيروقراطية التي ظلت تحت سيطرة دكتاتورية الأقلية 40 عاماً تقريباً (1971-2011) وشهدت على مدى السنوات الـ13 الماضية انهياراً تامّاً في العلاقات بين الإدارة المركزية وامتداداتها المحلية، تحظى بأولوية قصوى لاستعادة النظام العام.
ولتحقيق ذلك: يجب الاحتفاظ بالموظفين البيروقراطيين من الرتب المتوسطة والدنيا الذين لم يتورطوا في أي أنشطة إجرامية. يجب تيسير عودة الموظفين المؤهلين الذين فرّوا من البلاد خلال الحرب الأهلية هرباً من قمع الأسد إلى مناصبهم. يجب تعيين المهنيين المتعلمين تعليماً عالياً من ذوي الخبرة الدولية الكبيرة في مناصب قيادية متخصّصة. وينبغي إنشاء “لجنة للإصلاح المؤسّسي” تتألف من إداريين ذوي خبرة، للإشراف على جميع هذه العمليات، بما في ذلك تحديد الموظفين المناسبين وتعيينهم.
هذه التدابير أساسية لضمان الحوكمة الفعالة والتماسك المؤسسي في عملية الانتقال إلى سورية الجديدة.
التكامل العالمي والإقليمي: تعزيز علاقات سورية الدولية
في ظل حكم عائلة الأسد، الذي امتد أكثر من نصف قرن، عانت سورية علاقات متوترة مع جيرانها، مثل العراق وتركيا ولبنان والأردن ومصر، بينما بقيت سورية أيضاً حبيسة تحالفات حقبة الحرب الباردة. يجب التغلب على هذا التاريخ من العزلة، بينما تشرع سورية في وضع إطار جديد للسياسة الخارجية.
يوفّر موقع سورية الجيوسياسي إمكانات كبيرة لتصبح لاعباً محورياً في الدبلوماسية الإقليمية. ولتجنب النزعات الانعزالية التي غالباً ما تعقب الثورات، على الإدارة الجديدة أن تعطي الأولوية لتنمية شبكة علاقات دولية متوائمة استراتيجياً.
في البداية، يجب على الإدارة الجديدة اتخاذ عدة خطوات رئيسية: ضمان الاستمرارية في التمثيل الدبلوماسي من خلال الحفاظ على الدبلوماسيين المخلصين. استخدام القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى التزام سورية بالسلام والاستقرار، على الصعيدين الداخلي والإقليمي. الشروع بالتواصل العاجل مع دول المنطقة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لكسب الاعتراف وتعيين الممثلين. تشجيع الدول التي لديها سفارات مغلقة في دمشق على إعادة فتحها من خلال تقديم ضمانات أمنية. تبنّي موقف حازم ضد تصرّفات إسرائيل، خاصة تعاملها مع غزة، مع الدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة القنيطرة المحتلة، والسعي إلى الحصول على دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
على المدى الطويل، قد تؤسّس سورية نموذجاً جديدًا للسياسة الخارجية، يقوم على عدة مبادئ توجيهية: إقامة علاقات متينة ومحترمة مع دول الجوار، وضمان الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي. الثبات في دعم القضية الفلسطينية إلى حين إقامة دولة مستقلة. رفض التطبيع مع إسرائيل حتى انسحابها من الأراضي السورية المحتلة، ولا سيما مرتفعات الجولان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. تجنّب التورط في الخصومات الإقليمية والحروب بالوكالة. المساهمة في إنشاء إطار إقليمي للسلام والاستقرار في المنطقة. بناء علاقات متوازنة وبناءة مع القوى العالمية. المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية، مع التركيز على الأمم المتحدة، لتعزيز مكانة سورية العالمية.
وبتبني هذا النهج، يمكن لسورية أن تنتقل من العزلة إلى دور استباقي في الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.
ملاحظات ختامية
باختصار، نشهد ولادة سورية جديدة وسط عملية تتشابك فيها تحدّيات وفرص كبيرة. وبصفتي أكاديمياً ورجل دولة إقليمية، شهد نجاحات بارزة ومآسي عميقة في العلاقات الدولية، أدعو بجدّية إلى بذل الجهود لضمان عدم ذكر منطقتنا بالحروب والصراعات والمجازر، بل بالسلام والنظام والاستقرار والتنمية.
أتوجه أولاً إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي في الإدارة المؤقتة، وأخص بالذكر أحمد الشرع الذي قاد الثورة السورية، ويتحمل الآن مسؤولية الحكم. لقد منّ الله عليكم بنصرٍ عظيم، بعد أن تحمّلتم معاناة هائلة. ولكن هذا النصر لا يخصّكم وحدكم، بل يخصّ مئات آلاف من الشهداء الذين قدّموا أرواحهم بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية في المدن السورية، وعلى أيدي التعذيب في السجون.
مسؤوليتكم ثقيلة، لكنها نبيلة. قاوموا إغراء الانعزال في القصور الفاخرة. بدلاً من ذلك، ابقوا بين الناس الذين هم أصحاب هذه الثورة الحقيقيون. تجنّبوا الصراعات الداخلية، ولا تحصُروا أنفسكم في تحالفات ضيقة. ومن هذا المنطلق، عزّزوا ثقافة التعاون التي تشمل جميع أبناء الشعب السوري. لا تسندوا القيادة إلى مجرّد المقرّبين منكم، بل إلى أهل الكفاءة. دعوا الاقتداء بموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء فتح مكة يرشدكم في نهجكم. ركّزوا على إعادة البناء، وليس السعي إلى الانتقام، وأعطوا الأولوية لإنشاء سورية جديدة جامعة.
ثانياً، أدعو جميع دول المنطقة وقادتها، وأنا أعرف كثيرين منهم، إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري خلال هذه العملية الصعبة. دعونا نؤكّد أن “سورية ملك للسوريين”، ونمنع توريط سورية في حروب جديدة بالوكالة ومنافسات جديدة. ولا نقيم مناطق نفوذ من خلال التحيّزات العرقية والطائفية.
أقترح تنظيم “قمة لجيران سورية” في دمشق، تُصدر إعلاناً قوياً لدعم وحدة أراضي سورية والسلام الداخلي والتنمية الاقتصادية وعودة اللاجئين. على إيران التي دعمت نظام الأسد، أن تتجنّب تفاقم الفوضى في سورية. مصلحتها في ضمان أن ترسي الإدارة الجديدة استقراراً يشمل جميع المكوّنات، ويتصدّى لأطماع إسرائيل التوسّعية. انزلاق سورية مرّة أخرى إلى الصراع لن يفيد سوى إسرائيل، وليس إيران. على دول المنطقة أن تعطي الأولوية لمساعدة سورية على النهوض قوة استراتيجية، وليس ساحة معركة للفصائل المتناحرة.
ثالثاً، المهمّة الأكثر إلحاحاً عند القوى العالمية، خاصة الولايات المتحدة وروسيا، تأمين قرار من مجلس الأمن يضمن وحدة أراضي سورية، ويرفع الحظر المفروض على سورية، ويدعم العملية الانتقالية. الخطأ الأكبر الذي يمكن أن يرتكبه القادة الغربيون، ولا سيما ترامب، هو النظر إلى سورية من منظور أمن إسرائيل. غذّت هذه المقاربة الاستعمارية الجديدة، التي تربط مصير المنطقة بأمن إسرائيل، المشاعر المعادية لأميركا والغرب في المنطقة. أي محاولات من إسرائيل لضم الضفة الغربية أو إيجاد ظروف في جنوب سورية كتلك في لبنان، حيث تعمل إسرائيل بحرية، لن تؤدّي إلا إلى تصعيد التوتر. ولا يمكن للمنطقة أن تتسامح مع مثل هذه المشاريع التي تتمحور حول إسرائيل.
على إدارة ترامب أن تتخذ خطوات فورية لضمان الاستقرار الإقليمي، من خلال تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلها، ودعم حل جميع الجماعات والمليشيات الإرهابية في سورية. وأمّا في ما يخص روسيا، فنأيها بنفسها عن الإدارة الجديدة بسبب علاقاتها السابقة مع الأسد سيكون خطأ فادحاً. انخراط روسيا، سواء بشكل مباشر أو من خلال تركيا، مع الإدارة الجديدة سيكون حاسماً لمصالحها الخاصة والاستقرار الإقليمي. وستكون أهم مساهمة لروسيا في السلام الداخلي في سورية هي حثّ الأسد الذي تستضيفه، على الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تضر بهذه العملية الانتقالية الحاسمة.
وللمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، دور أساسي في ضمان سلاسة العملية الانتقالية في سورية. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي شهد معاناة سورية بصفته مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (2005 – 2015)، في موقع فريد من نوعه للمساهمة بشكل إيجابي في مستقبل سورية. ويمكن أن يوفر ضميره الإنساني العميق وخبرته الواسعة دعماً لا يقدّر بثمن في المرحلة الانتقالية المقبلة. عند انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة في عام 2016، قلت له عبر الهاتف: “إن صديقي الذي عملت معه في مخيمات اللاجئين، وعاين معاناة الشعب السوري، وهو الآن الأمين العام للأمم المتحدة يعطيني الأمل في مستقبل سورية”. واليوم يحتاج الشعب السوري إلى دعمه ودعم الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى. وأنا واثق بأن جهود السيد غوتيريس ستكون مفيدة في دعم سورية نحو الاستقرار.
وأخيراً، وكما ذكرت في مقال نُشر أخيراً باللغة التركية، لبلدنا مسؤولية تاريخية وإنسانية في هذه العملية. على تركيا أن تدعم بقوة تعافي سورية وتساهم في استقرار البلاد وسلامها وأمنها. العلاقات بين تركيا وسورية أكثر أهمية بكثير من مجرّد علاقة جوار، فهي قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين. سيعود بناء علاقة مبنية على هذه القيم بالنفع على كلا البلدين، خاصة عند النظر إلى الشتات السوري في تركيا، الذين يعودون بعد تحمّلهم المشاق، بحسن نية وروابط مع تركيا.
لقد حان الوقت لنموذج جديد للجوار، قائم على الفكر والاستراتيجية والأطر المؤسّسية، وليس على العواطف العابرة أو الخطابات الرنانة. لدى هذا النموذج من الاحترام المتبادل القدرة على تغيير مصير المنطقة التي تأثرت منذ فترة طويلة بالحدود المصطنعة التي أنشأتها القوى الاستعمارية. على تركيا أن تتصرّف بخطة استراتيجية واضحة وتقف إلى جانب سورية وتيسر مستقبلاً سلميّاً ومزدهراً.
في هذه الفترة الحاسمة، على المسؤولين الأتراك تأكيد أن: “هذه الثورة ملك للشعب السوري، وسورية ملك للسوريين. ونحن تركيا الدولة شاركنا الشعب السوري في معاناته وقدّمنا بيوتنا وقلوبنا. هدفنا الوحيد، في ما يتعلق بمستقبل سورية، أن يعيش هذا البلد الشقيق في سلام ووئام وازدهار. لم نسعَ يوماً إلى الهيمنة السياسية، أو تحقيق مكاسب اقتصادية من مستقبل سورية، ولن نفعل ذلك أبداً. لن نسمح لأي قوة، بما في ذلك إسرائيل، باستغلال معاناة سورية لمصالحها الاستراتيجية الخاصة. وستكون العلاقات التركية السورية نموذجاً مثالياً للسلام والازدهار في منطقتنا. وندعو جميع الدول الصديقة إلى دعم استقرار سورية وإعادة إعمارها”.
وختاماً، الطريق أمام سورية مليء بالمسؤوليات الهائلة، ولكنه أيضاً مليء بالفرص التي لا حدود لها، فبدعم من القوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الإرادة الثابتة للشعب السوري، يمكن لسورية أن تتغلب على المصاعب التي تواجهها وتخرُج أقوى مما هي عليه وتعزّز السلام والاستقرار والازدهار لشعبها والمنطقة. الطريق إلى سورية الجديدة مليء بالتحدّيات، لكنه يستحق العناء.
العربي الجديدة
—————————-
وثائق السيد (أَ): ناشط مجتمع مدني وممثل للمعارضة “الوطنية” في جنيف و”مندوب” في المخابرات السوريّة!/ فراس دالاتي
18.02.2025
توظّف المخابرات السورية “مندوبين” مميزين، يقدمون معلوماتٍ قيمة على المستوى الإقليمي والدولي مقابل “الحماية”و “توفير مساحة للعمل”. السيد (أ) واحد من هؤلاء الذين نتتبع نشاطهم ضمن سلسلة وثائق أمنية من شعبة الأمن السياسي في دمشق!
حصلنا في “درج” على مجموعة من الوثائق التي تكشف نشاط المدعو السيد (أ)، الذي يعمل “مندوب” للمخابرات العامة في سوريا، ضمن دوائر المجتمع المدني المحلي والدولي في سوريا، وتبوأ مقعداً في مفاوضات جنيف ممثلاً عن “المعارضة”. حكاية السيد (أ) وما تحويه من وثائق و”تقارير أمنية”، تتركنا أمام أسئلة عدة تتعلق بالعدالة الانتقالية وأسلوب محاسبة الفاعلين في نظام الأسد، والأهم، حق هذه الشخصيات في العودة الى العمل السياسي والمدني من دون محاسبة عن تاريخها الذي تسبب لا فقط بعرقلة الجهود الدولية تجاه سوريا بل أيضاً وصل حدّ توظيف التقارير لتصفية حسابات شخصية أودت بالبعض إلى سجون الأسد.
قصة السيد (أ) الذي اخترنا في “درج” إخفاء اسمه تطرح تساؤلات حول العدالة الانتقالية في سوريا وأسلوب المحاسبة الذي ما زال غامضاً، ويتحرك بين التصفيات الانتقاميّة والاعتقالات الرسميّة التي ترافقها لقاءات على وسائل الإعلام، المصلحة بوصلة اعتمدناها في بناء القصة، خصوصاً أمام غياب أشكال الاتهام القانونية لكاتب التقارير، ومدى مسؤوليته المباشرة عن اعتقال أحدهم ضمن هرمية العقاب في نظام الأسد.
شكَّل المُخبرون جزءاً ثابتاً من الحيّز العام السوري على مدار خمسة عقود حكم فيها الأسدان بقبضة من حديد، عبر قائمة لا نهائيّة من أفرع الأمن وشعب المخابرات، تلك التي خلقت وظيفة “كاتب التقارير”، وظيفة تمنح صاحبها نوعاً من الحصانة، وتفتح له أبواباً قد لا تكون متاحة له من قبل، وأحياناً تكون هذه الوظيفة جهداً شخصياً، أي أن يتبرع أحدهم من نفسه ليشغل هذه الوظيفة، ويتدرج مترقياً في سلّم المخبرين لدى أجهزة الأمن.
هذه الوظيفة تكشف أحياناً عن سبب وجود البعض في وظائف ومناصب قد لا يمتلكون مؤهلاتها، وحين السؤال عن السبب، يجيب المحيطون بهذا الموظف النشيط والفضولي بعبارة واحدة “هذا زلمة مخابرات”.
ملفات عدة حوَت مئات الوثائق التي اطَّلع عليها “درج” في إدارة المخابرات العامة بدمشق، اعتُبرت بمثابة عقود تعاون مع المُخبرين، الذين أُطلق عليهم في الوثائق الأمنية لقب “المندوبين” أو “المصادر”، وهي أوراقٌ تضمنت الاسم الكامل للمُخبر واسماً مستعاراً ورقم الهوية ورقم الهاتف والمهنة، مع ديباجةٍ تشبه تلك التي في عقود العمل، بما فيها من خدمات وتعهدات من الطرفين وعبارة “مستعد للتعاون”، يذيّل بتوقيع صاحب العلاقة/ المخبر.
مُعظم أولئك المتعاونين يعملون في مهنٍ تقوم في سوريا على نظام المُياومة وتخلو من كل ما يمت الى الرواتب الثابتة أو الضمانات الاجتماعية بصِلة؛ كسائقي التاكسي وأصحاب الأكشاك والباعة المتجوّلين، وبالطبع بائعي البالونات في مواسم الأعياد، وهذا ما يفسر المبالغ الضئيلة التي كانوا يتلقونها لقاء تقديم المعلومات.
بحسب مجموعة وثائق أخرى اطّلع عليها “درج” في مبنى المخابرات الجوية بدمشق، تبيَّن أن الفرع سيئ السمعة خلق ما يشبه حالة “اقتصاد العمل الحر” أو “الفريلانسينغ”؛ إذ كان “المندوبون” يتلقون رواتبهم كمبلغٍ مقطوع لقاء المعلومة الواحدة، ولم يكن يتجاوز الخمسة آلاف ليرة (نحو 7-8 دولارات عند طباعة الوثائق) للمعلومة الواحدة.
السيد (أ): مندوب مخابراتي دوليّ!
بعيداً عن المندوبين المياومين، توظّف المخابرات السورية ما يمكن وصفه بـ”المندوبين” المميزين الذين لا ينتمون إلى الفئات السابقة، والذين يقدمون بطبيعة الحال معلوماتٍ أكثر وأعلى قيمة من مجرد تحركات مشبوهة أو التفوه باسم “السيّد الرئيس” عبر الهاتف، والمقابل يكون نوعاً من “الحماية” أو “توفير مساحة العمل” لا على شكل مصروفات مالية. وهذه حكايةٌ تحكيها سلسلة وثائق أمنية صدرت عبر السنوات عن شعبة الأمن السياسي في دمشق، واطلع عليها “درج” بشكلٍ مباشر تخصّ المدعو السيد (أ).
تروي الوثائق حكاية مدير منظمة مجتمع مدني سورية وأحد وجوه “معارضة” الداخل “الوطنية” – بحسب سردية الأسد الفارّ وإعلام نظامه –السيد (أ) واظب لسنواتٍ عدة على حضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، واجتمع مع ممثلي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأوروبيين، وتبوأ مقعداً ثابتاً في مفاوضات جنيف وملحقاتها بهدف “إظهار دور المجتمع المدني بشكل فاعل وتقديم أوراق أعمالٍ لتوصيف المرحلة الدستورية والانتخابية المقبلة، وضرورة ملء الفراغ السياسي” حسب ما كان يُصرَّح لوسائل الإعلام.
تزامن نشاطه السابق مع التواصل الدوري والدؤوب مع الأجهزة الأمنية السورية، لتقديم معلومات تتعلق بنشاطات أو أفراد المنظمات المدنية الأخرى إقليمياً ودولياً؛ ما يشمل طبيعة المشاريع، تفاصيل العاملين، أو حتى بيانات حساسة قد تُستغل لإعاقة العمل المدني لتلك المنظمات، إضافة إلى التقييم والرأي الشخصيين بتلك النشاطات من “المعارض الوطني” في بعض المحاضر.
نقرأ في وثيقة صادرة عام 2018 عن شعبة الأمن السياسي، عن الدور الذي لعبه “ممثل المجتمع المدني” إيّاه بدفع عجلة التطبيع الأوروبي مع الأسد بصفته “مرساة الاستقرار”، والذي وصل ذروته قبل سقوط النظام بأشهر قليلة من خلال وثيقة “لا ورقة” قدمها سبع وزراء خارجية أوروبيين لمنسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى مغازلته الأفرع الأمنية السورية.
تحدَّث السيد (أ) في ورشة عمل في عاصمة أوروبية عن “ضرورة التفكير بواقعية أكثر من الدول المؤثرة بالمنطقة، وبخاصة الأوروبيين، وعدم الوقوف على الحياد والتواصل مع الحكومة السورية وفتح السفارات […] وإلا ستتحمَّل التبعات السلبية كنشر الإرهاب وزيادة عدد اللاجئين”.
يوثّق التقرير الأمني دفاعه عن الأجهزة الأمنية على الأراضي الأوروبية ومحاولات تمييع انتهاكاتها من منطلق “الجميع ارتكبوا جرائم”، إذ يقول في معرض ردّه على حديث أحد المشاركين بالورشة، بحسب الوثيقة الأمنية، القائل بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، إنه “يجب العمل أولاً على الاستقرار في سوريا ثم المحاسبة بشكل قانوني وليس بشكل حقدي، فإما أن يحاسب جميع الأطراف أو يسامح الجميع”.
حتى أنت يا غير بيدرسون!
ليس خفياً أن جلسات واجتماعات غير بيدرسن وغيره من ممثلي الأمم المتحدة في سوريا، كانت تُسجَّل وتُرسَل نسخ منها إلى أفرع الأسد الأمنية “للاطلاع واتخاذ المناسب”، وهذا ما ظهر في وثائق عدة اطلع عليها “درج”.كما أنه ليس خفياً إخفاق فريق غير بيدرسن في أداء مهامه خلال ست سنوات منذ تعيينه مبعوثاً أممياً إلى سوريا وحتى هروب الأسد؛ الإخفاق الذي تُوّج بإلقاء سيّدة من ذوي مفقودي سجن صيدنايا حذاءها نحو بيدرسن عندما زار السجن قائلةً: “أين كنتم طيلة 13 عاماً؟ تأتون الآن بعدما قُتل الجميع؟ أخرجوا فوراً من هنا!”.
ولهذا أسبابٌ عدة تترأسها مماطلة الأسد وإغراقه الأمم المتحدة بالتفاصيل والوعود والبيروقراطية، وحتى محاصرته إياها اقتصادياً بحصر عقود التوريد بيد المنتفعين الاقتصاديين المقربين منه الخاضعين للعقوبات.
في كثير من المواقف وجد السوريون والسوريات أنفسهم خائبين أمام تبنّي الأمم المتحدة سردية النظام التي حاول الترويج لها في المحافل الدولية وعبر الإعلام في ما يتعلق بالوضع المعيشي والأمني وقضايا اللاجئين. وفي هذا الصدد، أدّى “المواطن الصالح” السيد( أ) دوره على أتمّ وجه، إذ تكشف وثيقة أخرى صادرة عام 2019 عن وقائع لقاءٍ جمعه بغير بيدرسن في مكتب الأخير، تناقشا فيه حول اللجنة الدستورية ودور اللاجئين والنازحين السوريين في المشاركة السياسية، فقال فيه للمبعوث الأممي إنه “ليس هناك ما يمنع غالبية اللاجئين من العودة والمشاركة، أعتقد أن حوالى 90 في المئة من اللاجئين في أوروبا خرجوا لأسباب اقتصادية اجتماعية وليس لأسباب سياسية أبداً، فلا يمكن القول إن السلطات تطلب اعتقال أربعة ملايين شخص، وهذا مستحيل”.
فيما أفاد 50 في المئة من مجموعة لاجئين عادوا إلى البلاد بأنهم تعرّضوا، هم أو أحد المقربين منهم، في مناطق سيطرة النظام، لأنواع من الاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد بسبب موطنهم الأصلي، أو بسبب مغادرتهم سوريا بشكل غير قانوني، أو لتقديم طلب لجوء في الخارج، بحسب مشروع بحثي أطلقته منظمة “أصوات النازحين السوريين”، ومركز العمليات والسياسات، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، عام 2022.
الطريق إلى صيدنايا يبدأ بتقرير
تتجلّى المفارقة في الصورة التي رسمها “المواطن الصالح” لمبعوث الأمم المتحدة حول “الاستتباب الأمني” في سوريا عندما طلب نفسه العون من الأجهزة الأمنية، و”التعامل” مع من “يعيقون نشاطه المدني”، إذ يكشف كتابٌ مُرسل من فرع الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 19 أيار/ مايو 2024 إلى شعبة الأمن السياسي قدَّمه ناشط المجتمع المدني إياه، اتهامه عدداً من ناشطي المجتمع المدني والباحثين الاقتصاديين وموظفي المؤسسات الإقليمية المانحة، بأنهم يعيقون عمله في غرفة دعم المجتمع المدني، وأنهم أشخاص تابعون لـ “منظمات مشبوهة خارجية”.
وبحسب معلومات قدّمها أحد المطّلعين السابقين على القضية في شعبة الأمن السياسي لـ “درج”، نتج من ذاك التقرير إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض من وردت أسماؤهم فيه، فيما حوكم بعضهم الآخر غيابياً في القضاء العسكري بتهم التجسّس لصالح المعارضة الخارجية والتعامل مع دول معادية للحكومة السورية وتسريب معلومات أمنية مهمة و”المساهمة بالدفع نحو إقرار قانون قيصر 2″، بينما استُدعي من ورد اسمه في الكتاب وكان داخل البلاد، فحوكم بالتهم ذاتها بشكلٍ مباشر وسُجن في منفردة في صيدنايا لأشهر قبل أن يحُكم عليه بالإعدام بعد جلستين مع قاضي التحقيق، وخرج منه عند فتح السجون ليلة سقوط نظام الأسد.
الجدير بالملاحظة في ذاك التقرير الأمني هو ورود اسم منظمة “فري برس أنليميتد” (FPU) في سياق الحديث عن إعاقة عمل السيد (أ) المدني، إذ نقرأ في التقرير أن فريق المنظمة تجاهل تحركات (أ) بالكامل في بروكسيل وتجنب الحديث معه عندما علموا بالنشاط الاستخباراتي الأمني المرتبط بأجهزة الأسد لدى بعضهم.
عند سؤال “درج” أحد المطّلعين على تلك المجريات وأحد الحاضرين في تلك الورشة، تبيَّن أنَّ الأمر تجاوز “التجاهل وتجنب الحديث”، إذ كان من المقرر أن تقدم منظمة “فري برس أنليميتد” تمويلاً قدره 80 ألف دولار لمنظمة الناشط الأمني وألغته لاحقاً عندما علمت بعمله “الآخر”.
في العدالة الانتقالية
لم يذكر الناشط/ المندوب الأمني نفسه في الوثائق شكل “إعاقة العمل المدني” التي كان الفاعلون الآخرون يتسببون بها بما أدى الى تقديم تقارير كيدية بأسمائهم لجهاز الأمن السياسي، لكن خطة عمل وضعها سابقاً عام 2019 ربما تفسر جزءاً من “المشكلة” التي واجهها.
نقرأ في الخطة أن “المشكلة أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة لعمل المبادرات والنشاطات المدنية سواء على الأرض أو في المشاركات الخارجية مع غرفة دعم المجتمع المدني أو غيرها من اللقاءات التي تنظمها دول ومؤسسات خارجية، إذ بقيت الأمور في الإطار الأمني المتعلق بمعرفة الحضور والمداخلات بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التي تعمل جميعها برؤية حماية الوطن، ولكن وفقاً لتفسيرات مختلفة قد تتعارض في ما بينها”، إلا أنَّ المفارقة تكمن في أنَّ تلك الخطة الرامية للخروج من الإطار الأمني قدّمها إلى رئيس مكتب الأمن الوطني، ووصفها بأنها “خطة تضبط نشاط المجتمع المدني بالداخل بالتنسيق مع الدولة السورية وخاصة أجهزتها الأمنية”!.
سقط نظام البعث، وانهارت الأجهزة الأمنية، وبدأ الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقه على أيدي الحكومة التي تأتمر بأمر الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي عطَّل دستور عام 2012 وأعلن تشكيل لجنة متخصصة لصياغة دستورٍ جديد، فيما عاود “المواطن – الناشط – الصالح” إيّاه الظهور على الشاشات التلفزيونية الكبرى يتحدث عن ضعف الجهاز الأمني للنظام البائد وانتهاء صلاحيته، ذلك الذي كان لوقتٍ قريب يحكم مصائر كثر انطلاقاً من تقاريره.
يتحدث في لقاءٍ آخر عن وجوب إيجاد الإطار القانوني الجامع، هل هو “الناشط المدني” الذي يضع المحاسبة والمساءلة أعلى ضرورات المرحلة، أم “كتّيب التقارير” السابق المُعرَّض للانتهاك في أحد “التصرفات الفردية” لو وشى به أحد ضحايا كتُبه كما حدث مع كثيرين منذ شهرين والى الآن؟.
سؤال العدالة الانتقالية الذي يتحدث عنه “زلمة المخابرات” في أحد اللقاءات، يفتح الباب أمام شأن طارئ بخصوص الملفات والوثائق والتقارير الأمنية، لا فقط خوفاً من الانتقامات في حال نُشرت الوثائق الأمنية علناً، بل يخص أيضاً أسلوب المحاسبة نفسه، من لحظة كتابة التقرير بأحدهم حتى لحظة اعتقاله أو قتله، هناك هرمية للجريمة توزع على المتهمين، لكن هل هذا التقرير بالذات الذي كتبه أحدهم بآخر، هو ما تسبب بالاعتقال؟ خصوصاً أن هناك تقارير كُتبت بالكثيرين ولم تؤدّ إلى شيء، نحن هنا أمام مسؤولية قانونية حول آلية التعامل مع هذه الوثائق وكيفية توجيه الاتهام ومعاييره.
استشرنا المحامي السوري أنور البني، المدافع عن حقوق الإنسان بخصوص قضية “السيد أ”، فأكد أن إخفاء اسم السيد أ جزء من العدالة الانتقالية المرجوة ولحماية مسير أي تحقيق قد يُفتح بحقه. وفي الوقت ذاته، أكد أهمية الوثائق التي حصلنا عليها، والتي تفيد بمقاضاته في المحاكم الأوروبيّة، خصوصاً أمام شهادة واحد من ضحايا التقارير التي كتبها.
يضيف البنيّ أن التخوف حالياً في ظل غموض أساليب العدالة الانتقالية والتقاضي في سوريا، يوجب الحذر في التعامل مع هذه القضايا والوثائق والأشخاص المتورطين، خصوصاً أن “كتابة التقرير” أو “التواصل مع المخابرات السوريّة” أفعال لا تمتلك بعد قيمة قانونية داخل سوريا، لكن في العدالة الدولية هناك آليات للتعامل مع هذه الاتهامات وتحديد طبيعة الاتهام.
ختم البني حديثه معنا بضرورة الحفاظ على نسخ موثّقة من الوثائق وخاضعة للمعايير المهنيّة، والحذر في التعامل مع “المخبرين” إن صح التعبير، خوفاً من الجرائم التي قد تُرتكب بحقهم وضماناً لمسار العدالة في سوريا.
دؤج
———————————————–
حوارٌ وطنيٌّ في سورية أم مؤتمرٌ وطنيٌّ عام/ عمار ديوب
18 فبراير 2025
تمرّ سورية بمرحلة انتقالية، وبغض النظر عن الاختلاف مع الخطوات التي بدأت بها الإدارة الجديدة، حيث كان الأدق البدء بإصدار إعلان دستوري مؤقت، ينظم هذه الخطوات.
وتعني المرحلة الانتقالية في سورية تلاشي النظام القديم، من دون تسليمٍ دستوري للإدارة الجديدة، واستلام الأخيرة السلطة بالقوّة العسكرية، ما أفقد الإدارة، وأي إدارة بهذه الوضعية، الصفة الشرعية والدستورية. ويتطلب تجاوز هذه الإشكالية خطوات دستورية، للانتقال من “الشرعية الثورية” إلى الشرعية الدستورية.
وجدت الإدارة الجديدة نفسها في موقفٍ ضعيفٍ إذاً، واتخذت خطواتٍ لا تقود نحو الشرعية الدستورية، كاجتماع الفصائل، وانتخاب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وتكليفه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ووجد الشرع نفسه بمأزقٍ، فتشكيله للمجلس التشريعي المؤقت سيُقرأ تفرّداً بالحكم، داخلياً وخارجياً، فاتجهت الإدارة نحو الإعلان عن لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وجرى تشكيلها بتوجيه من الرئيس الشرع، باعتبار الحوار الذي سيمثل السوريين، سيؤمّن له شرعية التمثيل الشعبي، باعتبار الشعب مصدر الشرعية الدستورية. هنا، ارتكبت الإدارة خطأً جديداً، فبدلاً من أن تدعو إلى مؤتمرٍ وطني عام، ويمثل بالفعل كل السوريين، وعلى اختلاف تنوعهم الاقتصادي والسياسي والثقافي والقومي والديني وسواه، وأن تَصدر عنه هيئات سيادية لتنظيم شؤون الدولة، أي لوضع الخطط المحدّدة لعمل الدولة وسياساتها العامة وفي الميادين كافة، اتجهت الإدارة لإعلان لجنة تحضيرية للحوار الوطني، أي للحوار بين فاعلين سوريين، وإصدار توصيات غير ملزمة، وقد تأخذ أو لا تأخذ بها أو تأخذ ببعضها الإدارة الجديدة. وبالتالي، ليس من مهام الحوار الوطني المزمع عقده تشكيل هيئات سيادية، ولن تكون توصياته مُقرِّرة لخطوات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، وإقراره، وإجراء الانتخابات عامة.
نصّ الإعلان عن اللجنة التحضيرية يقود إلى إجراء حوارات وطنية، تنتهي ببيانٍ ختاميٍّ. وحوارات كهذه تجري وستجري وستظلُّ تجري وتصدر عنها البيانات، ولكنّها ستظلُّ خاصة ومحدّدة بالجهات التي اجتمعت وأصدرتها، وتوصيات المؤتمر المُعلن عنه لا تتجاوز هذه النتائج، وهذا يُذكِر بمؤتمر صحارى، الذي عقده نائب الرئيس الهارب، فاروق الشرع في يوليو/ تموز عام 2011، وجرى تهميشه بشكلٍ كامل، ولم يُسعف النظام في أيّة شرعية حينذاك.
متى تكون للحوارات أهمية وطنية بالفعل، ومتى تكون أقرب إلى الدستورية في المرحلة الانتقالية؟ تكون كذلك حينما تكون اللجنة التحضيرية وطنية بالفعل، وليست ممثلة لتوجهٍ سياسي وفكري محدّد، وحينما تكون عالمة بتفاصيل المجتمع السوري بعامة، وهذا ما تفتقده اللجنة التحضيرية؛ إن أغلب شخصياتها ليست من العاملين في الشأن الوطني العام، وأعمالها وفقاً لتعريفاتها العامة مقتصرة على قضايا تخصّ المجال الفصائلي، أو منظمّات المجتمع المدني والإغاثي، والمجال الدعوي، والسيدة هند قبواتي في قضايا التفاوض مع النظام المنحل. إن تعريفات تعوق أعمال اللجنة ذاتها وتدفعها إلى التجريب وتنفيذ توجهات الإدارة التي أوكلتها بالعمل. كان يمكن تجاوز ذلك بتعيين لجنة من الشخصيات الوطنية، التي على اطّلاعٍ واسع بتعدّدية المجتمع السوري وتنوعه القومي. الخلاصة هنا، لن تكون اللجنة قادرة على إجراء حوارات جادّة مع المدن السورية، بغية انتقائها الشخصيات التي تمثلها، ووصولاً إلى الشخصيات الأساسية التي ستتمثل في المؤتمر في دمشق.
إذاً لدينا مشكلتان وليست واحدة: تخصّ الأولى اللجنة التحضيرية التي لا تملك خبرات وطنية لإدارة الحوار، ونتائج الحوار ذاته، والتي ستكون بياناً فيه بعض التوصيات وفقاً لبيان التحضيرية ولتصريحات بعض شخصياتها، وبالتالي، لن يقدّم شرعية إضافية للإدارة الجديدة، ولن ينقلها إلى شكل إداري وسياسي أقرب إلى الدستوري والممثل للمرحلة الانتقالية.
في هذا الإطار، ستستمر الإدارة بخطواتها المستقلة عن المؤتمر، وسواء عُقِد أم لا، ولكنها ستستفيد منه إعلامياً وخارجياً، بأنّها أجرت حوارات مجتمعية ووطنية، وأنها تمثل الشعب، المتحاورين والإدارة. وبالتالي، لا بد من رفع العقوبات وتخفيف الضغط والنقد وتكليفها بإعادة الإعمار، وتشريع كل خطواتها. داخلياً، تتقصّد الإدارة بالحوارات القول إن المجتمع ليس مُبعداً، وجرى الأخذ بآرائه، وربما، وبظل التعقيدات الكبيرة، ولا سيما شعور السوريين العلويين بالضعف، فإنهم لن يمثلوا بشكل كافٍ، وكذلك بما يخصّ الدروز، وإن لتخوفاتٍ تتعلق بجملة التوجهات الإسلامية للإدارة، فيغيب التمثيل الجاد للأقليات الدينية بمؤتمر الحوار. وبالطبع، هناك موضوع الأكراد، والذي لا يزال مؤجّلاً، وقد أشار إلى ذلك أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، رغم جولات التفاوض التي تجري. ستُقرأ هذه التعقيدات خارجياً بأنها هيمنة لتيار الإدارة الجديدة على المرحلة الانتقالية، وهذا سيزيد من الضغط الخارجي، وسيتعقد المشهد الداخلي بمشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وربما أكثر من ذلك، فوضى أمنية مثلاً.
تُضيّع الإدارة الجديدة فرصة إضافية وزمناً آخر بابتعادها عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام، وهذا يختلف كليّة عن مؤتمر الحوار الوطني. تشكيل لجنة للمؤتمر الوطني العام هي المهمة الراهنة، وأن تتمثل فيها شخصيات قادرة فعلاً على تمثيل كل المدن السورية، وبما يُترك للأخيرة حريتها في اختيار شخصياتها، الأكثر وطنية، ومعرفة بشؤون مناطقها، وخصوصية الجماعات التي تتشكل منها، واحتياجاتها الاقتصادية والسياسية، وتتمتّع بالكثير من النزاهة والمعرفة والاطلاع على كيفية الانتقال الديمقراطي ونحو الديمقراطية. يكمن عمل اللجنة التحضيرية في بعض أوجهه في تسيير لقاءات المدن، وتحديد القضايا الأساسية للنقاش، والإشارة إلى تجارب بلدان أخرى، والابتعاد عن أية توجهات مناطقية أو طائفية أو عشائرية أو تقسيمية كذلك. عمل اللجنة التحضيرية شاق، وليس بسيطاً، وربما يتطلب إجراء نقاشات مكثفة مع كبار الخبراء السوريين، وفي مختلف المجالات، وهذا سيساعد على إدارة الحوارات الدقيقة مع المدن، واختصار أعداد الشخصيات التي ستَشترك في المؤتمر، والتي لا يجوز أن تتجاوز مائتي شخصية، وبالتالي، هناك جهد كبير، يقع على اللجنة التحضيرية ريثما ينعقد المؤتمر الوطني العام، وهذا أمر آخر غير ما كُلفت به اللجنة التحضيرية الحالية.
لا تحتمل سورية التجريب من جديد، وليس من الصواب أن تتجاهل الإدارة الجديدة تعقيدات الوضع السوري برمته، ولا الضغوط الخارجية. وفي مؤتمر باريس الجديد، قيل إن العلاقة مع دمشق خطوة مقابل خطوة. منذ وصول الإدارة الجديدة إلى دمشق هناك فرصة تاريخية، وقد لا تستمرّ، وهي التوافق الدولي والإقليمي في ضبط خلافاتها بما يخص سورية، ودفع إدارتها نحو عبور المرحلة الانتقالية من دون أن تفشل، كما الحال في السودان أو ليبيا، فهل تستجيب الإدارة لقراءات ومناشدات وطنية بالإعلان عن إعلان دستوري مؤقت ينظم أعمالها لعامٍ مثلاً، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، والدعوة لمؤتمرٍ وطني عام طوال هذا العام، ويساهم في نقل سورية بالفعل من المؤقتية إلى الدستورية، وإغلاق إرث الشرعية الثورية، التي ابتُليت بها سورية منذ 1963، والآن يعاد تجديد شبابها مع الإدارة الجديدة؟
العربي الجديد،
—————————–
قسد وخياراتها الأخيرة.. هل يفعلها مظلوم عبدي؟/ العقيد عبد الجبار العكيدي
الثلاثاء 2025/02/18
استطاعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منذ نشأتها في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة، أن تحجز موطىء قدم لها على الجغرافيا السورية، شأنها في ذلك شأن سواها من قوى الأمر الواقع، وذلك على أعقاب استفحال النفوذ الدولي بأشكاله المختلفة في سوريا. وبهذه الخطوة يكون حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، قد تحوّل من فرع لحزب العمال الكردستاني الذي لا يزال مُدرجاً على قوائم الإرهاب عالمياً، إلى قوّة تدّعي تجذّرها سوريّاً، تارةً بزيّ إيديولوجيا “الأمة الديمقراطية” وفقاً لصياغاتها الأوجلانية، وتارة باسم القضية الكردية، إلّا أنها في كلتا الحالتين تقع في تناقضٍ كبير يعود بها إلى نقطة الصفر، إذ إن “أفكار أخوّة الشعوب” والديمقراطية العابرة للأمم، هو شعار في الأصل يتناقض مع فكرة القومية الكردية التي يقف وراءها من يطالب بكيان سياسي مستقل للأكراد، باعتبارهم أصحاب وطن سليب أو متشظي بين دول أربع هي سوريا والعراق وإيران وتركيا.
ربما كان من نتيجة هذا التناقض، هي الهشاشة والارتباك في الخطاب السياسي لقسد وذراعها السياسي (مسد)، من جهة، وكذلك تبديل المواقع وإعادة إنتاج الشعارات من جهة أخرى، فما الذي تريده قسد، ومن خلفها حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا؟
ما من شك أن الحزب الاتحاد قد أطل على المشهد السياسي السوري عبر بوابة الثورة السورية عام 2011، إذ كان قبل ذاك التاريخ مجرّد حزب لا يخرج نشاطه عن دائرة المراقبة للمخابرات السورية، ولا يستطيع القيام بأي مبادرة مهما كانت محدودة الحجم، إلّا بتوجيه الجهات الأمنية التابعة لنظام دمشق، وحتى حين انطلقت الثورة السورية كانت إطلالته على المشهد السوري محصورةً بردع الأكراد المنتفضين عن نظام الأسد، ومنع تيار الثورة من الامتداد والانتشار في المناطق ذات الأغلبية الكردية، ولعل هذا المسعى وجد دعماً واضحاً من جهة نظام دمشق الذي كان بحاجة إلى هذا الدور، كحاجته إلى جميع الميليشيات الطائفية الدخيلة التي آزرت قوات الأسد في قمع المظاهرات السلمية آنذاك. وقد تطوّر هذا الموقف في أواسط العام 2012، حين بدأ النظام بالانكفاء العسكري نحو مراكز المدن الكبرى وسحب قواته من عدد كبير من البلدات والقرى والمدن السورية، كما قام بتسليم معظم عتاده العسكري لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي في أماكن تموضعها، وبهذا استطاع الحزب أن يتموضع عسكرياً في أماكن عديدة من سوريا، وخاصة المناطق ذات التواجد السكاني الكردي.
لكن الخطوة الأهم في تكوين قسد، تجسّدت بمبادرة واشنطن نحو إنشاء قوة عسكرية لمحاربة تنظيم داعش، ووجدت في الأذرع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي ضالتها من جهة أنه يمكن أن يكون كياناً عسكرياً قابلاً للتوظيف، دون أن يكون له أي شعور بالالتزام فيما يخص القضية السورية. وكانت الحرب على داعش في خريف 2014، إيذاناً بتحوّل قسد إلى كيان أمر واقع يبسط نفوذه على جميع المناطق والبلدات التي يتم طرد داعش منها، الأمر الذي جعل من الإدارة الذاتية، القوة التي تبسط سيطرتها على المناطق ذات الغلة الاقتصادية الأوفر في سوريا، وقد حاولت قسد استثمار أوراق قوتها تلك في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، بغية الحصول من سلطة دمشق على اعتراف فعلي باستقلالية الإدارة الذاتية، ولو تحقق ذلك لما كان لقسد أي مصلحة باستمرار ثورة السوريين، إلّا أن العقم الذي كان السمة الأبرز لنظام دمشق، لم يُتح لقسد الحصول على أي امتياز، ليس لحرص الأسد على البلاد السورية، بل لسمة متأصلة ببنية النظام البائد والمتمثلة بعدم تقديم أي تنازل، ليس للأكراد فحسب بل لجميع السوريين، وكذلك لقناعته الراسخة بأنه مالك العقار السوري الوحيد الذي يرفض مبدأ الشراكة في الحكم مع أي كان.
جزء كبير من اعتداد قسد بقوّتها، يكمن في رهانها الذي كان قائماً على استمرار بقاء الأسد في الحكم، كنظام ضعيف لا يقوى على مجابهتها في ظل استمرار المظلة الأميركية بحمايتها، وكذلك في ظل ممانعة أميركية لأي هجوم تركي من شأنه الإجهاز عليها، ولكن بسقوط نظام الأسد وانتصار ثورة السوريين فقد تغيّرت المعادلة. ولعل من أبرز سمات هذا التغيير هو الإجماع العربي والدولي على وحدة الأرض السورية وانصهار جميع القوى في بوتقة الدولة السورية الجديدة، الأمر الذي يجعل خيار قسد الوحيد هو التوجه نحو القيادة الجديدة في دمشق. إلّا أن هذا التوجّه والرغبة بالاندماج في الدولة السورية لا يزال مقروناً بتطلعات قسد القائمة على الاستقلال الذاتي والاحتفاظ بكافة المكاسب والامتيازات السابقة، أي لن يكون هذا الاندماج – وفقاً لما تريده قسد – سوى شرعنة وحماية وتحصين لمكتسباتها السابقة، في حين ترى حكومة دمشق أن انضمام قسد إلى بنية الدولة السورية ينبغي أن يكون كانضمام بقية الفصائل العسكرية وانصهارها في وزارة الدفاع، ولعل هذا التباعد في وجهتي النظر أو المواقف يمكن أن يتحوّل إلى صدام في لحظة يدرك فيها الطرفان أن قسماً كبيراً من الحل ما تزاله تختزله فوهات البنادق، إلّا أن الطرفين يتفقان في الوقت ذاته، على عدم الاستعجال، طالما أن الموقف الحاسم لإدارة ترامب ممّا يجري في سوريا لم يتبلور بعد، وفي هذه الحال لا يرى كلا الطرفين أي بأس من إبداء أمارات المرونة وتفضيل سبل الحوار والتفاوض.
يمكن القول إن منظمة المجتمع الكردستاني، والتي تسيطر على الأحزاب الكردية الأربعة، في تركيا (حزب العمال الكردستاني)، وفي سوريا (حزب الاتحاد الديمقراطي)، وفي إيران (حزب الحياة الحرة)، وفي العراق (حزب الحل الديمقراطي)، قادت أكراد سوريا خلال سنوات الثورة إلى أفق مسدود وحجمتهم وأبعدتهم عن ملعب التسوية السياسية، بل وضعتهم في مهب الرياح من خلال تحويل مناطقهم وأبناءهم الى ساحة لتصفية الحسابات مع تركيا، وإيهامهم بقيام كيان كردي مستقل.
يشاع منذ وقت طويل أن معركة خفية تجري في كواليس القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، بين مظلوم عبدي، ومعه قادة الأكراد السوريين الأوجلانيين الوازنين، وبين جمال باييك وأزلامه في سوريا وتركيا، مدعومين من إيران، في محاولة انتزاع أكراد سوريا قرارهم من جبال قنديل وقادته، ودفع عجلة قيام مصالحة مع المجلس الوطني الكردي والأحزاب والتيارات الكردية الأخرى، ليكونوا كياناً كردياً واحداً في إطار التسوية السورية الشاملة.
فهل يفعلها مظلوم عبدي وأمثاله من أكراد سوريا؟ أم انهم ينتحرون على مذبح خدعة كبرى ويتجاوزهم الزمن؟
المدن
———————————
لبنان وسوريا:صراع بين “فوضى الانهيار” وتفاؤل “الدعم الدولي”/ منير الربيع
الثلاثاء 2025/02/18
هل أُوصِلَ لبنان إلى ما وصل إليه من انهيارات مالية، سياسية، اقتصادية، أمنية وعسكرية، ليعود وينهض؟
وجهة نظر شديدة التشاؤم في قراءتها لتطورات الوضع في المنطقة وانعكاساته على الساحة اللبنانية، ترى أن إيصال لبنان ومختلف دول المشرق العربي إلى هذا الدرك، لم يكن تمهيداً لاستعادة عافيتها، بل إغراقاً متعمداً في أزماتها.
لا شك أن بشائر إيجابية كثيرة برزت في لبنان وسوريا، منذ سقوط نظام الأسد إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، والتي صاغت بياناً وزارياً متقدماً جداً بما يخص تعزيز الدولة ومؤسساتها. ولكن سريعاً ما وُضع لبنان أمام استحقاق مواجهة مخاطر كبيرة على المستوى الداخلي، أو مستوى العلاقة مع الخارج، كما هو الأمر بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تواجه تحديات داخلية وخارجية.
يسعى البلدان إلى استعادة تعزيز قوة وسيطرة الدولة على كامل الجغرافيا، وحصر السلاح بيدها بالإضافة إلى الانتقال بمشاريع وخطط على المستويات السياسية والاقتصادية، ولكن هناك مواجهات كبرى ستفرض على كلا السلطتين في البلدين. ومن أبرز التحديات ما يتصل في مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي والإداري وفي إعادة ترشيد وتنشيط مؤسسات الدولة. سريعاً، بدأ يظهر حجم الضغوط الدولية، فعلى الرغم من الصورة المأخوذة للاحتضان الدولي والعربي للسلطتين الجديدتين، إلا أنه بالمعنى الفعلي لم يحصل البلدان حتى الآن على أي عناصر أو مقومات دعم، لا بل تُمارس ضغوط دولية كبيرة عليهما، كما هو الحال في لبنان بالنسبة إلى وضع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة في مواجهة حزب الله بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول الرهان على الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب، ما يعني وضع الطرفين في مواجهة بعضهما البعض. لا ينفصل ذلك عّما تسّرب من وقف لكل المساعدات الأميركية للبنان، وهذه المساعدات التي ستكون مشروطة بالإصلاحات التي سيتم إنجازها.
يعني ذلك أن لبنان سيكون خاضعاً لضغط كبير لإحداث تغيير وتحول في كل مساراته، ربطاً بالسعي للحصول على تلك المساعدات، بما فيها إعادة الإعمار والتي لن تتم قبل إنجاز الإصلاحات المشروطة دولياً بما يتصل بمعالجة وضع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وهم أمر لن يستسلم له الحزب بسهولة ما سيرفع منسوب التحدي. كذلك الأمر بالنسبة إلى كل ما يتصل بالتعيينات والتغييرات الإدارية وبالسياسات العامة التي ستعمل السلطة الجديدة في لبنان على وضعها واعتمادها.
في سوريا أيضاً، تفيد المعلومات بأن الأميركيين لم يتخذوا أي قرار حتى الآن برفع العقوبات ولا بتقديم المساعدات التي من شأنها أن تحسن ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتمنح سلطة أمنية وعسكرية قوية للنظام الجديد، وذلك حتماً سيكون مرتبطاً بدفتر شروط كبير.
وقع البلدان في انهيارات كبيرة على وقع صراعات داخلية وخارجية. جرى الانتقال إلى سلطات جديدة، بعد حروب كبيرة. لكن هناك تخوف من استبدال الحروب الخارجية بحروب داخلية وحالات اقتتال أو توتر مستمرة. بما يتناقض مع مبدأ تعزيز سلطة الدولة. مؤشرات هذا المشروع تظهر من خلال الإصرار الإسرائيلي على البقاء في نقاط متعددة في الجنوب مع التمتع بحرية الحركة برياً أو جوياً وفي عمليات الاغتيال ومواصلتها، ووضع لبنان تحت ضغط وجوب نزع سلاح حزب الله والذي بحال لم تنجح الدولة بالقيام بهذه المهمة فإن إسرائيل ستواصل عملياتها. ذلك ما يهدد قدرة الدولة على الإمساك بالسلطة وقرار الحرب السلم بخلاف البيان الوزاري، وبخلاف كل المسار الداخلي والخارجي. لا سيما أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي سيعيد تفعيل عمل المقاومة، وسيتمسك حزب الله بسلاحه أكثر فأكثر، أما الصراعات الداخلية والاحتجاجات ستشغل الجيش اللبناني بين المناطق المختلفة، وتبعده عن الجنوب ولن تمكنه من توسيع انتشاره هناك والإمساك بكل مفاصل الأرض، وهذا بحدّ ذاته سيكون متناقضاً مع مبدأ تعزيز الدولة وتقويتها وحصر السلاح بيدها. إنها مرحلة جديدة بالتأكيد، فيها الكثير من الإيجابيات التي يبنيها الشعبان اللبناني والسوري، لكنها مرحلة تتصل أيضاً بمخاطر كبيرة، قد تتجلى بمحاولات لنقل الصراع من الخارج إلى الداخل.
المدن
———————————————
الشرع في عفرين واللاذقية.. ما الأهم؟/ عمر قدور
الثلاثاء 2025/02/18
في اليوم الأول من جولته الداخلية، ذهب الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة عفرين، ذات الأغلبية الكردية، في سابقة هي الأولى من نوعها. إلا أن خبر زيارته عفرين سرعان ما توارى خلف الصور الواردة من زيارته اللاذقية، ثم طرطوس، لتُحمَّل زيارته المدينتين أبعاداً رمزية وانتصاريةً.
كأنّ قدر الكرد ألا يستفيدوا من تسليط الأضواء عليهم، لأنها راحت سريعاً إلى الجانب الأكثر “إثارة” للأغلبية العربية، أي الجانب الطائفي. ولأن هذه الأغلبية، التي قلّما تتفق، لا توجد بين معظمها خلافات ذات شأن تتعلق بالنظر إلى الموضوع الكردي في سوريا. ولو نالت الزيارة اهتماماً من الجانب العربي لكان من المرجّح أيضاً أن تحرّض اهتمام الكرد، ولو من زاوية أنها أول زيارة رئاسية هم معنيّون بها منذ الاستقلال، والأمر يتعلق هنا بمقام الرئاسة ورمزيته.
لا نبالغ، ولا نريد أن نبخس الموضوع الكردي حقه، إذا قلنا أن أولى درجات القضية الكردية في سوريا تتعلق بالاعتراف. يوماً ما، سُرَّ بعض الكرد بعبارة قالها بشار الأسد، وهي أن “الأكراد جزء من النسيج السوري”. بالطبع، هو إنشاء يؤكد المؤكَّد أصلاً، إلا أن قوله آنذاك أرضى من رأوا فيه اعترافاً بالوجود الكردي، خصوصاً بالمقارنة مع أصوات عروبية، داخل السلطة وخارجها، تنزع عن الكرد أصالة وجودهم في سوريا.
قد يُقال، عن حق، أن السوريين تحت سلطة العهد البائد كانوا جميعاً بحاجة إلى الاعتراف، فسعيُ تلك العصابة الحاكمة كانت دؤوباً لطمس السوريين من عرب وكرد وسواهما. الحاجة إلى الاعتراف هي بمثابة الحاجة إلى الشعور بالكرامة البشرية، والتي لا يحققها سوى الإحساس بالمواطنة غير المنقوصة، أو غير المسُستلَبة، وهذا كان في أصل ما ثار السوريون من أجله.
لقد سُلبت كرامة السوريين خلال عقود من تغييبهم سياسياً، والتعميم يجب ألا يُستغل إطلاقاً لإنكار خصوصية تغييب الكرد، وللقول أن المظلومية السورية واحدة تماماً، وحلُّها لا يجب أن يلحظ أية خصوصية لأية جماعة. ما عانى منه الكرد خلال حكم البعث والأسد هو إنكار السلطة لهم، والأنكى هو إنكارهم من قبل الثقافة العروبية المهيمنة خارج السلطة أيضاً، وهذه الثقافة لا تزال حاضرة بمسمّيات مختلفة ذات طابع إقصائي، وإن لم تظهر بحمولة أيديولوجية على غرار العقود الماضية.
الأسابيع الأخيرة مثلاً شهدت تحريضاً على وسائل التواصل، صدر بمعظمه عن أنصار العهد الجديد، يطالب أصحابه السلطة بمهاجمة أماكن سيطرة قسد والإدارة الذاتية لإخضاعهما للمركز. وعلى الضد من ذلك، تم قبل يومين تداول خبر اتفاق المركز مع قسد لشراء غاز من الحقول التي تسيطر عليها، أي أن الرئاسة والحكومة تتعاملان بواقعية على الأرض، ولم تسايرا الضخ الحربي على وسائل التواصل، والأسوأ أنه مصحوب كالمعتاد بما يعمّق الهوّة بين العرب والكرد.
الردح بين الجانبين ليس مستجداً، وهو يتكرر بين مناسبة وأخرى. والمؤسف ألا تلوح في الأفق تباشير تقارب بينهما على مستوى القواعد والمستقلين، بحيث يلعب المجتمع على الطرفين دوراً إيجابياً. البلد بعمومه لم يخرج بعد من آثار الاستبداد، والمجتمع المغيَّب طوال عقود بحاجة إلى وقت ليمتلك روح المبادرة ثم زمامها. مبادرة، كذهاب الرئيس إلى عفرين، قد تشجّع على ما هو إيجابي، فيما لو أُعيد تسويقها بعد انتهاء جولته لدى الجمهور الذي انصرف انتباهه إلى المحطات اللاحقة.
في كل الأحوال، المبادرة بحاجة إلى تعزيز لاحق كي تؤخذ بجدية لدى الجمهور على الطرفين، ولدى الجمهور الكردي المستهدف بها أولاً. جدير بالذكر أنه ليس للشرع شخصياً إرث سلبي لدى الكرد، كما هو حال السمعة السيئة لفصائل العمشات والحمزات وقياداتهما. على هذا الصعيد، سيكون من المفيد والضروري في آن متابعة الشكاوى التي قُدِّمت خلال الاجتماع معه، لأن جبر الخواطر أولاً، ومن ثمّ جبر الضرر، خطوتان ممكنتان ومستحقتان وتعززان فكرة الاعتراف التي أشرنا إليها، وما يتصل بها من الكرامة البشرية.
لم نُشِر فيما سبق إلى إحقاق العدالة، لأن فكرة العدالة لا تبدو واقعية الآن، أو قابلة للتنفيذ سريعاً، بعد ما يزيد عن عقد من الانتهاكات متعددة الأطراف. ويُفترض بالواقعية أيضاً أن تحكم المفاوضات حول مستقبل الكرد ضمن الدولة السورية، مع الأخذ بالاعتبار العامل التركي المؤثر، والضاغط عند اللزوم. سقف المطالب الكردية محكوم بالجار الذي لا يطيقه معظم الكرد، لكن في المقابل لا حيلة لهم إزاء الجغرافيا. هنا أيضاً يمكن للمركز أن يلاقي الواقعية الاضطرارية الكردية بروحية الاحتواء، لا بروحية الاستقواء على الكرد، سواء كان الاستقواء بالجار التركي أو بالأغلبية العربية في الداخل. مثلما يتعيّن على الكرد عدم الركون إلى الدعم الخارجي، بل التصرف على أنه مؤقت.
ومواجهة الكرد بأغلبية عربية استدعت دائماً النظر إليهم ككتلة منسجمة، واصطفافهم تالياً ككتلة واحدة. للعرب خلافاتهم البينية، وللكرد خلافاتهم البينية كذلك، وللطرفين (من الجانب الإيجابي) تنويعاتهما التي تدحض وهم الانسجام. دولة المواطنة الحقيقية، وصونُ الحقوق الفردية فيها أولاً، هي مكسر الأيديولوجيات بمختلف أنواعها، ما يقتضي تحقيق الكرامة السياسية للجميع، كي تأخذ حقوق الجماعات الحيز المناسب فلا تكون على حساب حقوق الأفراد.
الوصفة الأسوأ لكسر الاصطفاف هي بالمراهنة على الإتيان بأشخاص من أية جماعة، بحيث يُمنحون صفة تمثيلية لها غير معترف بها ضمن الجماعة نفسها. مع الأسف هذا ما يُنذر به حديث هدى الأتاسي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، إذ قالت إن لجنتها لن تذهب إلى الحسكة والقامشلي على غرار المدن الأخرى، بما أن قسد لم تنضوِ تحت لواء الجيش الوطني، وبدلاً من ذلك ستستأنس اللجنة بآراء أفراد يأتون من الحسكة والقامشلي للقائها خارجهما. وبصرف النظر عن التحفظات من هنا وهناك على اللجنة وأدائها، فاستبعاد مناطق سيطرة قسد نهائياً هو أفضل من اعتبارها ممثَّلة على نحو يصادر إرادة نسبة كبرى من سكانها، فيعيد المشكلة إلى نقطة عدم الاعتراف بهم وبكراماتهم البشرية والسياسية.
من المؤكد أن السلطة الحالية، وهي تقدّم نفسها كسلطة انتقالية، غير مناط بها اجتراح حل جذري للموضوع الكردي في سوريا، ومن ثم تطبيقه. إلا أنها قادرة على البدء بما يطمئن الكرد إلى مستقبلهم في الدولة السورية، وعلى تبديد وهْم التعارض بين مصالح العرب والكرد ضمن الدولة العتيدة. ما تكلَّمَ حتى الآن، من هنا وهناك، هو لسان المأزومين والخائفين الذين لم يُتح لهم العيش بكرامة، أولئك الذين أُجبروا على العيش في الماضي بدل العيش في المستقبل الذي يستحقونه فرادى ومعاً.
المدن
——————————
أشباح سجن صيدنايا الرهيب!/ ماجد كيالي
18.02.2025
السجن السوري يختلف عن أي سجن في العالم، إذ إن سجون نظام الأسد لا تنتزع من الإنسان حريته، وحقوقه القانونية، وخصوصيته الفردية، وكرامته، وأدميته، فقط، وإنما هو سجن يفقد فيه المعتقل ذاته وروحه، وحتى أحاسيسه.
لم أسمع بسجن صيدنايا الرهيب بعد الثورة السورية فقط، إذ كنت أسمع عنه وعن غيره، وبخاصة سجن تدمر، الذي ربما كان أكثر هولاً منه، قبل ذلك بثلاثة عقود، مع قصص الزنازين المهولة لأجهزة المخابرات السورية المتعدّدة، التي تعج بها المدن السورية، لا سيما دمشق، حيث كنت أسمع حكايات من أصدقاء كثر كانوا مروا بتلك التجربة الفظيعة، سواء لأشهر معدودة، أو لأكثر من عشرة أعوام.
بينما كنت أسمع قصص أصدقائي وسيرتهم في المعتقلات، في بعض اللحظات، كانت رجفةٌ تسري في جسمي، مع شعور بنوع من الذهول، ربما كان يأخذني التخيل إلى شيء لم أكن أستطيع تصوّره، ويفضي لي إلى كوابيس مزعجة ومرعبة.
كنت أتخيل هذا الصديق، أو ذاك، ككائن مستضعف، وقد سلب آدميته، وبات مجرد مختبر لأفانين من التعذيب، إذ ليس الغرض سحب معلومات، أو الإذلال، وإنما التعذيب لأجل التعذيب، وهذا أقسى، وأكثر وحشية، من القتل، لأن القتل ينهي المسألة، بينما التعذيب يبقي الألم، الذي لا يمكن تحمّله.
لا يقتصر الأمر على التعذيب المباشر، فالعيش في السجن هو بحدّ ذاته عذاب، ومعاناة لا يمكن تخيّلها، فكيف إذا كان هذا السجن مثل سجن صيدنايا، أو تدمر، أو قبو لجهاز مخابرات، وكلها أمكنة لا تمت الى الإنسانية بصلة، إذ هي مجرد لبشر منسيين، أو مقابر أحياء، بل وأكثر قسوة ووحشية من ذلك، فهذه أمكنة جهنمية، بكل معنى الكلمة.
السجن السوري يختلف عن أي سجن في العالم، إذ إن سجون نظام الأسد لا تنتزع من الإنسان حريته، وحقوقه القانونية، وخصوصيته الفردية، وكرامته، وأدميته، فقط، وإنما هو سجن يفقد فيه المعتقل ذاته وروحه، وحتى أحاسيسه.
تخيلوا أن الحديث هنا يتعلق بأشخاص كل ما فعلوه أنهم حاولوا أن يكون لهم رأي آخر، أن يقولوا غير ما يقوله النظام، أن يطالبوا بحقوقهم بالحرية، وبالكرامة، وبالمشاركة السياسية، أو بأشخاص كل ما فعلوه أنهم قرأوا ورقة لتنظيم معارض، أو صدف أن مرّ في بيتهم شخص معارض، أو تجنى عليهم مخبر صغير لغرض ما، أو تقصدت شخصية سياسية أو عسكرية محوهم من الحياة لأي سبب.
في أثر الأصدقاء…
أتت مناسبة دعوتي من الإعلامي الفلسطيني واصل حميدة للمشاركة في إعلان تأسيس رابطة للمعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا (14/2/2025)، وصدف أن تعرفت في هذه الزيارة إلى عدنان القصار، الفارس والسجين، الذي أمضى 22 عاماً في السجون السورية، وضمنها سجن صيدنايا، وذلك لمجرد أنه فاز على باسل الأسد، الذي آثر التخلّص منه، في فورة غضب، بزجّه في السجن، 22 عاماً فقط!
كانت تلك الزيارة غير المخطّط لها واردة في ذهني، أي إنني كنت أريدها، أو كنت أتحيّن أي فرصة للقيام بها، كنت أريد أن أعرف كيف أمضى أصدقائي سنواتهم تلك في هذا السجن الرهيب، أو في غيره. كنت أريد أن أعرف، أو أن أرى أين كانوا، أو ما هو هذا المكان الذي كانوا فيه… أين وكيف كانوا يمضون أوقاتهم… كيف ناموا أو أكلوا أو اغتسلوا أو نادموا… ما الذي كانوا يروه من أماكنهم… ما الذي حلموا به…
شيء ما كان يدفعني لأن أعرف ذلك… كأنه نوع من العرفان لهؤلاء الذين حفروا الأساس لانهيار نظام الأسد، الذي ظن أن سوريا مزرعة خاصة لهذه العائلة المافيوية، التي تبينت عن شخصيات تافهة ووضيعة، وتصرفت كأنها لا تمت بصلة لا الى سوريا ولا الىى شعبها…
في زيارتي تلك إلى سجن صيدنايا، كان معي، في مخيلتي، كل أصدقائي من المعتقلين السياسيين السابقين، أصلان عبد الكريم، وسمير الحسن، وأنور بدر، وأكرم البني، وفضل السقال، ونبيل إبراهيم، وهؤلاء أمضوا في معظمهم أكثر من 12 عاماً في سجون سوريا، أكثرها في سجن صيدنايا، وأكثرهم خرج من السجن وقد وجد ابنته أو ابنه في ريعان الشباب، أي أنهم حُرموا وأبناؤهم من أهم لحظات العمر… في هذا السجن، أيضاً، زجّ نظام الأسد لسنوات عدة، أواسط الثمانينات، عشرات من منتسبي حركة “فتح”، من معظم مخيمات سوريا.
كانت للحظة الدخول إلى هذا السجن رهبةٌ، إذ يجب أن تقطع طريقاً طويلاً، من البوابة الخارجية الرئيسية إلى البوابة الداخلية، قد تستغرق نصف ساعة مشياً على الأقدام، في الحر أو في القر، كأن ذلك كان مخططاً لإرهاق وإذلال أهالي المعتقلين، الذين كان يسمح لهم بالزيارات أحياناً.
وأنا أعبر هذا الطريق الطويل (في سيارة)، الذي يأخذنا إلى المرتفع الذي بني عليه السجن، والذي يبدو من بعيد كقلعة صماء، في منطقة جرداء، تذكرت أم سمير وأختيه أمل وحنان، وقد حدّثنني مراراً عن مصاعب تلك الزيارة، لا سيما أنهن كنّ يقطعن تلك المسافة مشياً على الأقدام، وكل واحدة منهن تدفع أمامها عربة مليئة بالمواد التموينية مع ملابس وأغراض أخرى (مسموح بها) لرؤية سمير، وهذا ما كانت تفعله منى أسعد، زوجة أنور، مع طفلتها، آنذاك، يارا، لرؤية زوجها، وكي تتعرف يارا على أبيها.
متاهة الموت
السجن كهيكل كل شيء فيه حديد، وإسمنت مسلح، ويبدو كمبنى مسخ، أو مسلخ، وهو سُمي أخيراً كذلك. ومنذ البداية تجد نفسك في متاهة أو في سلسلة متوالية من بوابات حديدية، كل واحدة تفضي إلى أخرى، ثم تصل إلى “كريدور”، بنوافذ علوية ضيقة، يضم مهاجع عدة، تُغلق بباب حديدي ضخم، وللمهجع فتحات تهوية على الكريدور، من فوق الباب وتحته. علماً أن السجن محاط بأسوار عدة، وهو ممتد على مساحة كبيرة تضاهي مساحة بلدة كاملة، والمشكلة أن وراء كل جدار واحداً آخر، وثمة مع الجدران، حقول ألغام، وأسلاك شائكة، وحرّاس، بمعنى ألا أحد يستطيع الخلاص من هذا السجن.
أيضاً، في كل واحد من هذه المهاجع، كان يعيش عشرات من المعتقلين معاً، فيها يمضون أوقاتهم، وتضيع حياتهم، خارج العالم، وفي عزلة عنه، يعيشون كل نفس منهم، وكل مشاعرهم، جنباً الى جنب، فهنا ينامون ويقومون ويتحدثون ويأكلون، ويمشون، ويقضون حاجاتهم في ركن في الزنزانة، في البرد وفي الحر، وفي اليأس وفي الأمل.
في المهاجع كانت هناك ثياب متناثرة على الأرض، تلك التي كان المعتقلون يرتدونها داخل السجن قبل تحريرهم، وقد تركوها عندما خرجوا، عندما انهار نظام السجن السوري، مع الأسد الفار، كنت أرى كأن كل قطعة ثياب تحكي قصة عن فظائع هذا السجن.
وسقط الأبد…
كانت لحظات رهيبة وتبعث على الحزن والأسى والغضب، في الوقت ذاته، ذلك اليوم في سجن صيدنايا، وعند المغادرة لفت انتباهي أن هذا السجن الرهيب يقع على طريق صيدنايا ومعلولا، البلدتان الجميلتان، ذات التاريخ، ومقصد السياح من كل العالم، والأمر ذاته ينطبق على سجن تدمر، الذي لا يقل في فظاعته عن سجن صيدنايا، كأن كل ذلك الظلم والاستبداد لم يكف نظام الأسد، فزاد الأمر كل هذا القبح، المتمثل بتلك السجون، فهذا ما فعله نظام الأسد في شعب سوريا وجغرافية سوريا وتاريخها، لذا الأمل أن يتخلص شعب سوريا من تركة هذا النظام إلى الأبد.
عند خروجنا من السجن، من الجدار الأول، لفت انتباهي عدنان القصار إلى الجدار البعيد، الذي يتلوى كأفعى على مساحة كبيرة في محيط السجن، وقال وهو يؤشر بيده: هذا هو “الأفق” الذي كنا نراه طوال سني سجننا هنا”…
يا عالم: مجرد إسقاط نظام الأسد الوراثي، الذي حكم سوريا قرابة ستة عقود، بالخوف والرعب والفساد والاستبداد، هو ثورة بحد ذاته، لذا لو كانت ثمة عشرة أسباب لإسقاط نظام استبدادي هنا أو هناك، فثمة مئة سبب للخلاص من نظام الأبد الأسدي إلى الأبد.
درج
——————————-
التنمية الاقتصادية المتوازنة تُنقذ سورية من وحش التشدّد/ عبد الباسط سيدا
18 فبراير 2025
تعيش منطقتنا منذ إعادة هيكلتها على الصعيد السياسي، قبل نحو قرن، مرحلة عدم استقرار على المستوى الداخلي الخاص بكل دولة، وعلى المستوى الإقليمي بين مختلف الدول. ويمكن ملاحظة ذلك في موقفين متعارضين متنافيين، إن لم نقل متناقضين يطبعان بميسمهما وشمين يرمزان إلى توجّهين غير متكاملين في رؤية الأنظمة العسكرية الجمهورية التي حكمت دول منطقتنا، وهي دول رسمت حدود معظمها اتفاقيات الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. التوجه الأول تجسّد في تمسّك السلطات المحلية بحدود تلك المساحات التي أصبحت دولاً مستقلة لها أعلام وجيوش وأناشيد وطنية خاصة بها. أما التوجه الثاني فقد تجلى في سعي تلك الدول، في الوقت نفسه، إلى شرعنة ذاتها أمام الداخل الوطني، برفع شعارات تحرير الأرض وتوحيدها ضمن إطار دولة قوية تستطيع مجابهة القوى المعادية ومخطّطاتها. وهذا ما كان على وجه التخصيص في مصر وسورية والعراق؛ وهي البلدان التي شهدت ولادة أحزاب قومية الأيديولوجيا، ولكنها مع ذلك كانت متخاصمة إلى حد التناحر، الأمر الذي يؤكّد الطابع الوظيفي لشعاراتها الكبرى الخاصة بالتحرير والتوحيد.
وفي مواجهة تلك السلطات العسكرية التي تمترست بالأيديولوجيا القومية، كانت المعارضة التي تشكّلت من قوى متعدّدة التوجهات، شملت القوميين المختلفين أيضاً، ولكن التيار الأقوى بين تلك المعارضة كان الإسلامي، الإخواني تحديداً، خاصة في سورية ومصر، وإلى حد كبير في العراق أيضاً، رغم خصوصيته المتمايزة عن خصوصية كل من سورية ومصر.
واعتمد الإسلاميون الدعوة إلى دولة الخلافة وتوحيد الأمة أيديولوجية تعبوية، تمكّنت من استقطاب جماهير واسعة من المؤيدين والمؤازرين الذين وجدوا في الهدف المعلن من الإسلاميين هدفاً يستحق العمل من أجل الوصول إليه، والتضحية في سبيله. ولإنجاز ذلك، وفق ما كانوا يصرّحون، كان التخلص من حكم العسكر في مقدّمة الأولويات، فهذا الحكم كان يعد، وفق حساباتهم، العقبة الأساسية أمام تنفيذ مشاريعهم التي كان تتمحور حولها جهودهم في ميدان العمل، من أجل الوصول إلى السلطة وبأي ثمن.
أما في منطقة الخليج، فالملاحظ أن الأيديولوجيا بصورة عامة لم تصبح هي الموجّه لحكوماتها، رغم التزامها بالعروبة الاجتماعية الثقافية، إذا صحّ التعبير، ولكن من دون أن تتحوّل إلى صيغة من صيغ العروبة السياسية لتستخدم أداة للشرعنة، ومحاولة توسيع النفوذ من خلال رفع شعارات كبرى. والأمر نفسه بالنسبة إلى الأيديولوجيا الإسلامية، فرغم الطابع المحافظ الذي اتصفت به المجتمعات الخليجية بصورة عامة، وما زالت؛ ظلّ نزوعها العام نحو التدين المعتدل غير المتشدّد، وحتى السلفية التي ظهرت في بعض البلدان الخليجية ظلت، في توجهها العام، معتدلة لم تتبنّ، بصورة عامة، التوجّهات التكفيرية العنفية التي انتشرت لاحقاً في جملة من دول الأنظمة الجمهورية العسكرية.
وكان من اللافت أن الإدارة الرشيدة في تلك المجتمعات قد تمكّنت من تأمين الحاجات الأساسية لمواطنيها، خاصة من جهة تأمين فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية، بفضل الإدارة العقلانية للموارد، والمشاريع التنموية الاستراتيجية. في حين أن شعوب دول الجمهوريات العسكرية، رغم وجود الإمكانات، كانت تعاني من ناحية من الصعوبات المعيشية، نتيجة فساد (واستبداد) السلطات التي كانت تحكمها؛ وكانت، في الوقت نفسه، تدفع ضريبة تلك الشعارات الكبرى التي كانت ترفعها السلطات المعنية ومعارضاتها في الوقت نفسه، وهي شعاراتٌ أراد بها أصحابُها تفسير السلبيات التي كانت تعاني منها مجتمعاتهم، عبر اتّهام الآخرين، والتنصّل من المسؤولية، فتارّة كانت التهم توجه من الأنظمة العسكرية للاستعمار والقوى الإمبريالية والرجعية والصهيونية المتآمرة على الأمة، بهدف الحيلولة دون تحرّرها ووحدتها وتقدّمها، وتارّة كانت التهمة توجّهها التيارات الاسمية المعارضة إلى القوى التي لا تريد الخير للإسلام والمسلمين، وتعمل على تحطيم الدين الإسلامي. وفي الحالتين، كان يسود الخطاب المتشدّد، سواء القومي التخويني أو التكفيري التفجيري الديني المذهبي، وما زال.
وما كان، وما زال، يعطي دفعة للاتجاهات المتشدّدة، القومية منها والدينية المذهبية في منطقتنا، يتمثل في جملة عوامل خارجية وداخلية، في مقدّمتها إحساس الناس بالمواقف غير العادلة التي تتّخذ على المستوى الدولي تجاه قضاياهم، واعتماد سياسة الكيْل بمكيالين، وتلمّسهم لها بصورة شبه يومية. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى القضية الفلسطينية، التي كانت باستمرار بمثابة الحافز الدافع للتيارات القومية والدينية، لارتباطها الوثيق بالجانب الوجداني لدى العرب والمسلمين، وقدرتها على إثارة المشاعر والتعبئة الشعبية في الداخل الفلسطيني، وبين أوساط الشعوب العربية والإسلامية؛ ولعلّ هذا ما يفسّر سرّ حرص النظام الإيراني على استغلال هذا الموضوع وتوظيفه في خدمة سياساته التوسّعية في دول المنطقة، هذا إلى جانب جهوده في ميدان استغلال المظلوميات الشيعية، ومحاولاته المستمرّة على صعيد إحداث تغييرات بنيوية في المجتمعات المجاورة، بغية تأمين حاضنة شعبية مساندة لتوجّهاته التوسّعية، بالتنسيق مع أذرعه من المليشيات المحلية واعتماداً عليها.
وتتمثل العوامل الداخلية في جملة عوامل، في مقدّمتها الاستبداد الذي كانت تمارسه، وتمارسه راهناً أنظمة عربية عسكرية تغلّفت بالشعارات القومية، وتستّرت بواجهات ديمقراطية شكلية؛ فكانت الصدامات عنيفة بينها وبين معارضاتها، لا سيما الإسلامية منها. إلى جانب الاستبداد، يُعدّ الفساد من بين العوامل التي أثارت حفيظة مختلف الشرائح الشعبية في دول عربية عديدة، خاصة الشرائح التي تعيش أصلاً بؤساً معيشياً نتيجة دخلها المحدود، وشعورها بأن لشقائها علاقة مباشرة بالتوزيع غير العادل للثروات، وتحكّم فئة محدودة العدد بمقدّرات الوطن. وما يزيد في درجة تعقّد الأوضاع وسوئها، يتمثل في ضعف إمكانات الدول المعنيّة، وإخفاقها في عملية جذب الاستثمارات، بفعل أسباب عدّة، منها عدم وجود الاستقرار، وغياب القوانين الواضحة الشفافة التي تضمن حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى غياب البيئة الآمنة المستقرّة، الأمر الذي يستبعد التفكير في مشاريع حيوية استراتيجية بعيدة المدى، والتركيز، في المقابل، على تلك الآنية الاستهلاكية التي تحقّق ربحاً سريعاً، غالباً ما يجري تقاسمه بين المستثمرين والمسؤولين المحليين، أو من يمثلهم من الواجهات بأسماء رجال الأعمال. ولتجاوز الشعارات المتشدّدة والسلوكيات المترتبة عليها، وإبطال مفعولها، تبقى التنمية المستدامة خير علاج للمحافظة على الأمن والاستقرار الداخليين، فهي التي توجِد فرص العمل، وتعزّز ثقة الناس بأنفسهم والمستقبل، وتنتشلهم من براثن الحركات الأيديولوجية المتشدّدة بكل ألوانها وتوجّهاتها، وتبيّن لهم أهمية الانفتاح على الجوار الإقليمي والفضاء العالمي بعقلية استيعابية، تنشد التشارك، والعمل على قاعدة المصالح المتبادلة.
وبناء على ما تقدّم، نرى أن سورية اليوم، بعد كل ما شهدته من تدمير لاجتماعها وعمرانها من سلطة بشار الهارب، في حاجة إلى تنمية حقيقية متوازنة، تستثمر في الإنسان السوري، أولاً، المعروف برغبته في العمل، وقدرته على الإبداع، وتفانيه في سبيل تحسين شروط حياته وتطوير بلاده وازدهارها.
ولتهيئة الأرضية أمام هذا الإنسان، ليتمكّن من العطاء والإبداع، ويقدّم لمجتمعه كل ما هو مفيد، لا بد من توفير الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي، وذلك لن يحدث من دون مصالحة وطنية شاملة تؤسس للمستقبل، وتقطع بصورة نهائية مع الماضي الديكتاتوري البائس الذي عانى منه السوريون جميعاً أكثر من 60 عاماً؛ منها 54 عاماً من حكم سلطة آل الأسد المستبدّة الفاسدة. ولكن المصالحة الوطنية لن تكون مستدامة، ما لم تكن مرتكزة إلى أسس عادلة، في مقدمتها محاسبة كل من أجرم بحقّ السوريين أمام قضاء عادل نزيه وشفاف.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج السوريون إلى توفير الشروط والمقومات الضرورية اللازمة لعملية الإقلاع بالعجلة الاقتصادية على مستوى البلاد بأكملها، وفي جميع الميادين. وهذا لن يتحقق من دون مساعدة المنتجين، ودعمهم ليتمكّنوا من الإسهام الفاعل في عملية بناء صرح اقتصادهم الوطني، وتخفيف حدة ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها السوريون اليوم في مختلف الأماكن؛ وهذا كله يتطلب بطبيعة الحال محاسبة الفاسدين القدامى، وسدّ المنافذ على الفاسدين الجدد، فمخاطر الفساد في يومنا الراهن، وفي الظروف التي نعيشها، تعادل مخاطر الإرهاب والتشدّد والاستبداد، إن لم نقل إنها تتجاوزها من جهة التأثيرات السلبية في البلاد والعباد، فالفساد يلتهم كل شيء، ويدمّر المجتمعات والدول. ويمكن الاعتماد في هذا المجال على كثير من الطاقات السورية الوطنية في الداخل والخارج. ولدينا اليوم أعداد كبيرة من الشباب السوريين المؤهلين في سائر الاختصاصات الضرورية، هؤلاء الذين أرغمتهم جرائم بشار على اللجوء إلى مختلف الدول، لا سيما دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، فهؤلاء تعلّموا في أرقى الجامعات، وأتقنوا اللغات، ولديهم خبرة واسعة في ميادين الاتصالات مع الحكومات والمؤسّسات والشركات التي تستطيع مساعدة السوريين من دون أي مس بسيادتهم، أو تدخل في شؤونهم.
ولعله من الأمور البدهية أن يُشار هنا إلى أهمية بناء العلاقات المتوازنة مع الجوار الإقليمي والمحيط الدولي، وذلك وفق قواعد الاحترام المتبادل، وعلى أساس المصالح المشتركة، والعمل الجماعي من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وحل القضايا والخلافات الموجودة، لا سيما القضية الفلسطينية بمنطق الحوار والتفاهم والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية.
تحتاج سورية إلى جهود سائر أبنائها، ولبلوغ ذلك ينبغي العمل المتواصل من أجل إزالة كل العراقيل التي تحول دون مشاركة السوريين على مستوى الأفراد والجماعات. ستتحقق العملية التنموية الوطنية الكبرى في حال إعطاء الأولوية للولاء الوطني مقابل كل الولاءات الفرعية، أو الولاءات العابرة للحدود الوطنية؛ وهي لن تتحقّق ما لم تكن بجميع (ولجميع) السوريين الملتزمين بوحدة وطنهم ومجتمعهم، وبأهمية مصالح شعبهم. ومثل هذه العملية لن تنجز في غياب عدالة لا يطالها الشك، عدالة تساوي بين السوريين جميعاً أمام القانون من دون أي تمييز أو استثناء؛ مع احترام الخصوصيات والحقوق.
العربي الجديد،
——————————–
خيانة الذاكرة/ فوّاز حداد
18 فبراير 2025
على مدار ما يزيد عن نصف قرن، تراكمت في الذاكرة الجماعية للسوريّين صُور مروّعة من المعتقلات، والمجازر طاولت مدنيين أبرياء دونما تمييز. كان الموت الحاضر الأكبر والأوحد، حتى بات من الصعب إحصاء الجرائم التي ارتُكبت أو حتى توثيقها بشكل كامل. هناك عائلات بأكملها اختفت بلا أثر، تحت ركام البيوت المهدّمة بالقصف الجوي، ورجال وشبّان أُبيدوا في ظلام السجون، ودُفنوا في مقابر جماعية. وهناك روايات عن اعتقال الأب والأُمّ والأطفال معاً؛ قُتل الآباء والأُمّهات تحت التعذيب، بينما احُتجز الأطفال في زنازين مجهولة، أو وُضعوا في دُور أيتام تحت أسماء مستعارة، وأُلصقت بهم ذاكرة زائفة. ما يعرفونه عن أنفسهم شيءٌ غامض، لكنّه ليس الحقيقة أبداً.
لم يكن الضحايا مجرّد أرقام، كان كلُّ منهم مأساة إنسانية، حُرمت من أي حقوق، فالزنازين عبارة عن مسالخ بشرية. تُمارَس فيها أبشع أنواع الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي مع التجويع. تلك الفظائع لم تكن مجرّد تجاوُزات فردية من الجلّادين، بل كانت سياسة ممنهجة.
أمام هذا الواقع المرير، يُطرَح سؤال مصيري: ماذا يعني السِّلم الأهلي في بلد مُثقَل بهذا الكَمِّ من المآسي؟ هل يعني طمس الحقائق، والتغاضي عن معاناة الضحايا، لمجرّد إعادة الاستقرار واستمرار الحياة؟ أم أنّ العدالة شرطٌ أساسي لتحقيق السَّلام؟
هناك من يروّج لفكرة السِّلم الأهلي دون محاسبة، مُعتبرين أنّ العدالة الانتقالية قد تُشعل فتيل الفتنة من جديد، بينما الحياة تتطلّب تجاوز ما حدث، وكأن شيئاً لم يكُن، المستقبل ما يهمّ وليس الماضي، ولكن، أليس تجاهل آلام الضحايا وحقوقهم انتهاكاً آخر لكرامتهم، حتى بعد موتهم؟
إن مواجهة هذا الإرث الدموي تتطلّب عدالة حقيقية وشجاعة. لا يُمكن إرساء سلام مستدام من دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها. فالعدالة ليست الثأر، بل ضرورة وطنية لضمان عدم تكرار هذه المآسي، وإن اعتقد البعض أنّ خيانة الذاكرة هي السبيل الوحيد للخلاص من دوّامة العنف، فالنِّسيان هو ترياق الانتقام، والوسيلة الوحيدة لمنع الدخول في أعمال عنف متبادلة تؤدّي إلى استعادة الحرب الأهلية التي مهما أنكرناها أو أخفيناها، فقد حدثت وشاركت فيها مليشيات طائفية مذهبية. لا نجهل أن الأغبياء ومنهم سياسيون ومثقّفون، يحرّضون تحت عناوين مشبوهة مشابهة، على إشعال فتنة يستفيدون منها لإسقاط السلطة الجديدة.
لا يُمكن بناء سلام حقيقي على النّسيان. إن تجاهُل الماضي سيفتح الباب أمام عودته، قد تبدو خيانة الذاكرة حلّاً سريعاً، لكنها في الواقع تأجيلٌ للمواجهة الحتمية مع الحقيقة. فالمجتمع الذي يدفن ماضيه دون محاسبة، يحكم على مستقبله بأن يظلّ رهينة لهذا الماضي.
العدالة الانتقالية ليست مجرّد عقاب للمجرمين؛ إنها عملية تهدف إلى تحقيق الإنصاف للضحايا. إن ترسيخ المصالحة الوطنية، يعني بناء نظام قضائي عادل ومستقلّ، لا يخضع لضغوط السياسة أو نوازع الثأر، بل يستند إلى مبادئ القانون وحقوق الإنسان. بدون عدالة انتقالية حقيقية، يصبح الحديث عن التسامُح والمصالحة شعارات فارغة. فالاعتراف بمعاناة الضحايا، وتقديم الجُناة إلى المحاكمة، خطوة أُولى نحو الشفاء المجتمعي. إنّ التجاهل المتعمّد، يُهدّد بإعادة دورة العنف من جديد.
في الوقت ذاته، يجب أن تكون العدالة وسيلة لبناء المستقبل، ما يتطلّب سرديات تصالُحية حقيقية، تعترف بالماضي دون أن تؤجّج الكراهية، وتفتح الباب أمام حوار وطني يشمل جميع الأطراف دون إقصاء. لذلك، يتعيّن على السوريين مواجهة ماضيهم بجُرأة، بلا إنكار أو تزييف. عليهم أن يكتبوا تاريخهم، ليكونوا قادرين على تجاوز آلامهم، والمُضي قُدماً نحو مستقبل مشترك يجمعهم كمواطنين متساوين، بغضِّ النَّظر عن انتماءاتهم الدينية أو العِرقية أو السياسية.
إنّ الخروج من دائرة الدَّم، يتطلّب إرادة سياسية صادقة، وقضاء مستقلّاً، إن توافرهما يسمح بعدم محو الماضي، وإنما تحويله إلى درس يحمي المستقبل. هذا هو مثلّث العدالة الانتقالية: الاعتراف، والمحاسبة، والمصالحة.
أما التحدّي، فيكمن في تحقيق التوازن بين حقّ الضحايا في العدالة وبين حاجة المجتمع إلى المصالحة، ولا عفو من دون محاسبة، والعدالة ليست الانتقام. إنما تعني بناء مجتمع جديد، وسورية جديدة، خالية من الكراهية، يسودها القانون.
ولا بأس بألّا يغيب عنّا، أنّ الذاكرة هي نحن، وما المصالحة إلّا مع الذات.
* روائي من سورية
العربي الجديد،
——————————-
السخرية إذ تساهم في تشكيل صورة قادة/ سميرة المسالمة
18 فبراير 2025
على مرِّ التاريخ، استخدم العديد من الزعماء السخرية بطرق مختلفة، سواء في الحروب الكلامية أو لإضفاء الطرافة على المواقف الجادة، مما جعلهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي. على سبيل المثال، كان ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، من أكثر القادة شهرة بعباراته الساخرة. ومن أبرز مواقفه، عندما قالت له السياسية البريطانية نانسي أستور: “لو كنتَ زوجي، لوضعتُ لك السم في الشاي!”، فردَّ قائلًا: “ولو كنتِ زوجتي، لشربته فورًا!”. لم تكن هذه الردود مجرد نكات، بل عكست شخصيته القوية وبديهته الحادة والحاضرة.
في سورية أيضًا، استخدم الزعماء السخرية للتلميح إلى مواقف جادة أو سياسية مصيرية، ومن ذلك ما قاله الزعيم السوري شكري القوتلي لجمال عبد الناصر عند توقيع اتفاقية الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 محذرًا له من صعوبة التعامل مع الشعب السوري وطموحاته: “أنت لا تعرف ماذا أخذت يا سيادة الرئيس، أنت أخذت شعبًا يعتقد كل فرد فيه أنه سياسي، ويظن خمسون بالمئة منهم أنهم زعماء!”. وقد نقل الصحافي محمد حسنين هيكل هذه المقولة في أحد مقالاته بعد ثلاثين يومًا من انهيار الوحدة، وللتأكيد على أن السوريين قد حذّروا عبد الناصر من أن قيادتهم ليست بالأمر اليسير عليه.
وعلى الرغم من أن السخرية يمكن أن تكون أداة ذكية في السياسة، فإن استخدامها غير المدروس قد يرتد على صاحبه. فقد حاول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد استخدامها كوسيلة “لتخفيف دمه”، لكن عباراته غالبًا ما تحولت إلى دليل على افتقاره إلى الحكمة. فعندما دعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع لحل الأزمة السورية، ورفضها مرة ومرات، سأله صحافي من قناة “سكاي نيوز” عن سبب رفضه للقائه، فرد بعبارة غير مسؤولة: “لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لكي نشرب المرطبات يعني مثلًا؟”. لم تكن هذه الجملة نكتة سياسية بارعة، بل كانت مثالًا على غياب الرؤية الاستراتيجية. والمفارقة أن معارضيه بعد أشهر قليلة، هم من احتفلوا لاحقًا بهروبه خارج البلاد، وربما جميع السوريين شربوا مرطبات النصر عليه، وإسقاط نظامه مع كل المسؤولين العرب والأتراك والغربيين الذين جعلوا من دمشق مزارًا لهم.
ما يعني أن السخرية المفيدة تعتمد على من يستخدمها، ومن يعرف حجم ما يستطيعه، وما يعجز عنه. فنابليون بونابرت استخدم السخرية بمهارة في الحروب والمفاوضات، وكان واثقًا من قدراته. مثال على ذلك، عندما تلقى رسالة تهديد من أحد خصومه كُتب فيها: “إذا هاجمتني، سأقضي عليك!”، فرد نابليون ساخرًا: “إذًا؟!”، في إشارة إلى يقينه بالانتصار، كما يقال إنه حين استعرض خارطة العالم، لم يتأخر عن البكاء عند رؤية موقع إنكلترا، لأنه كان يدرك أنها عصية عليه، فعبّر عن عجزه بدموع السخرية من نفسه، فالسخرية قد تكون أداة قوية، لكنها تحتاج إلى حكيم يدرك متى وأين يستخدمها.
لم تقتصر السخرية السياسية على الزعماء، بل كانت أيضًا وسيلة للنقد الشعبي، سواء علنًا أو سرًا. فمنذ العصور القديمة، استخدمت الشعوب السخرية للتعبير عن الإحباط والسخط من الحكام. في روما القديمة، انتشرت همسات التهكم حول فساد الأباطرة، وفي عهد الاتحاد السوفياتي السابق، كان المواطنون يتداولون السخرية عن جوزيف ستالين همسًا، خوفًا من بطشه. ومن الطرائف الشهيرة المتداولة في مصادر متعددة: “أحد المواطنين يسأل: هل صحيح أن ستالين يكافئ المزارعين على إنتاج القمح؟ فيرد الآخر: نعم، بالطبع! يرسلهم إلى سيبيريا ليزرعوه هناك”.
وفي العصر الحديث، استمرت السخرية السياسية كوسيلة للتعبير عن مشاعر الشعوب تجاه حكامها، ففي سورية، استخدم الباعة المتجولون وأصحاب “الدكاكين” عبارات تجارية ذات أبعاد سياسية خلال تسويقهم لمنتجاتهم، مثل “كل عضة بغصة يا سفرجل”، و”خلص موسمك يا أفندي”، و”حامض أكثر من عيشتي يا ليمون” للإشارة إلى المشاكل الحياتية في ظل الأنظمة الحاكمة.
وكذلك في مصر، انتشرت النكات السياسية خلال حكم جمال عبد الناصر، لكنها بلغت أوجها في عهدي أنور السادات وحسني مبارك، حيث أصبحت تعبيرًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومن النكات المصرية الشهيرة في عهد مبارك: “واحد يسأل صاحبه: لو مسكت عفريت المصباح، تطلب منه إيه؟ قال: أقوله شوف لي عفريت أكبر منه يشوف لي شغل” تعبيرًا عن واقع البطالة المزري الذي وصل إلى حد يفوق قدرة البشر على معالجته، وهو واقع ينسحب على بلدان جمهوريات عربية كثيرة.
صحيح أن السخرية تهدف غالبًا إلى التخفيف من عبء الواقع المثقل بالهموم، لكنها تبقى إحدى أدوات النقد القوية، وهي قد ترفع زعماء أو تسقط آخرين، كما ساهمت السخرية في تشكيل صورة بعض القادة كأذكياء ومحنكين، وكشفت عن سذاجة وغباء وسطحية آخرين. فبينما يمكن أن تكون السخرية علامة على الحكمة والدهاء، فإن استخدامها الأجوف قد يحوّل صاحبها إلى مصدر للسخرية بحدّ ذاته، كما حدث مع الأسد، الذي لم يفت الرئيس الحالي أحمد الشرع الإشارة إلى عبارته “هل نشرب المرطبات مثلًا”، واستذكرها أكثر من مرة تصريحًا، أو إشارة وهو يشرب الشاي مع ضيوفه من على جبل قاسيون، ولعل الهارب يشرب الآن “المرطبات” في منفاه، على نار الشك والخوف وبطعم الهزيمة والذل.
*كاتبة سورية.
ضفة ثالثة
————————————-
إعلان العلا أكبر من تعهد بإعادة إعمار سوريا/ علاء شاهين صالحة
18 فبراير 2025 م
تشكل المبادرة غير المسبوقة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالصراعات بداية بسوريا إدراكاً للفرصة النادرة لإعادة الاستقرار لركن من المنطقة كان على مدار سنوات ساحة لحروب إقليمية وأزمات اقتصادية طاحنة. النجاح غير مضمون، لكنّ هناك أسباباً رئيسية عدة تدعوني للتفاؤل.
هذه مهمة لا تستطيع دولة واحدة مهما بلغ حجم قدراتها المالية القيام بها؛ لأن التحدي هنا لا يكمن فقط في توفير دولارات إعادة الإعمار، ولكنه يمتد لإعادة بناء مؤسسات أنهكتها الحروب، ونخر في عظامها الفساد؛ لذلك كان مشجعاً أن يضم الإعلان ممثلين عن الصندوق والبنك الدوليين وعدد من بنوك التنمية العربية إضافة إلى دول المنطقة.
ستكون مسؤولية هذه المجموعة تحديد الاحتياجات المالية وغير المالية للاقتصادات المتضررة، على أن يتم حشد الأموال اللازمة من المجتمع الدولي. لم يحدد البيان حجماً تقريبياً للخسائر أو لتكلفة هذه الجهود. هذا طبيعي، لأن المؤسسات الدولية لا تعلم حتى الآن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوري وحده بعد 14 سنة من الحرب الأهلية.
ولعل السبب الرئيسي لحماستي هو أن البيان الصادر على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة تجاوز مرحلة إعلان مؤتمرات المساعدات الدولية التي اعتدنا عليها، والتي ينتهي بها الأمر عادة للإنفاق على إعادة إعمار ما هدمته الحرب… انتظاراً لحرب أخرى.
سئمنا إعادة الإعمار. اليوم لا يحتاج لبنان إلى منازل وطرق جديدة فحسب، ولكنه بحاجة لإعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي بالكامل لطيّ صفحة أقسى أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. سوريا ليست بحاجة إلى إعادة تأهيل بنيتها التحية فحسب، ولكنها بحاجة أيضاً إلى إصلاح مالي واقتصادي ومؤسساتي كامل. كل هذا يحتاج إلى أموال طائلة لا تستطيع أي جهة أن تتحملها وحدها، لكنه يتطلب أيضاً دراسات وخبرة وتطبيق إجراءات سياسية واقتصادية قد تكون مؤلمة في البداية. يحتاج لمؤسسات تَبْنِي اقتصاداً يشمل الجميع بدلاً من أن يعبّر عن مصالح طبقة محدودة من السياسيين أو المنتفعين.
يتسق البيان مع توجُّه سعودي وخليجي يربط أي مساعدات مالية بإصلاحات تضمن كفاءة الإنفاق لتفادي تكرار الأزمات، وهو ما نجده هنا من خلال مشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين. هذا يعني أن على الدول المستفيدة الالتزام بخريطة طريق تضمن تطبيق أي إجراءات متفق عليها.
ما جعل مثل هذا الإعلان ممكناً هو الانهيار غير المتوقع لنظام بشار الأسد، وما يعنيه ذلك من تراجع للدور الإيراني في سوريا ولبنان. هل هناك رد فعل أفضل من حشد الجهود الإقليمية والدولية لمحاولة ضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية؟
غني عن القول أن نجاح المبادرة يبقى رهن عوامل عدة، أولها توافر موارد عربية ودولية ضخمة ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. النجاح يحتاج أيضاً إلى التزامات من دول التي عانت سنوات من عدم الاستقرار والانقسام. المشوار سيمتد سنوات لكن البداية جاءت على مستوى الحدث والطموح.
صحافي لبناني. عمل مديراً لتحرير وكالة «بلومبرغ» في الشرق الأوسط وأوروبا. يشغل حالياً منصب مدير التدريب وتطوير المحتوى في «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام».
الشرق الأوسط
———————————
كيف تنتقل سوريا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية؟/ عبد الرحمن الحاج
أكاديمي وباحث متخصص في الحركات الإسلامية
18/2/2025
مضى على آخر تجربة حوارية وتفاوضية بين أطراف ممثلة للسوريين من أجل بناء نظام الدولة نحو ثلاثة أرباع قرن، ففي عام 1950 كُتب الدستور الثالث للدولة، وهو آخر دستور شرعي، وقد سبقه دستوران، دستور 1930 الذي كتب في ظل الانتداب الفرنسي، ودستور 1920 الذي كتب عبر المؤتمر السوري العام، كما أن هذه هي المرة الثانية أيضًا التي يقيم السوريون مؤتمرًا وطنيًا عامًا منذ أكثر من مائة عام، كان أول مؤتمر قد عقد في مايو/ أيار 1919، وكانت فكرة المؤتمر وقتها أن يكون مجلسًا تمثيليًا للأمة السورية، وأجريت انتخابات وفق النظام المعمول به في ظل الدولة العثمانية، وشمل 85 عضوًا ثم أضيف إليهم 35 من رؤساء العشائر والطوائف.
اعتبر المؤتمر نفسه مجلسًا نيابيًا وتأسيسيًا في آن معًا، فوضع الدستور عام 1920، وأعلن الاستقلال وقيام المملكة السورية، حدث ذلك في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث كانت الدولة العثمانية تنهار، وتسعى الدول الاستعمارية إلى تقاسم المنطقة، كما هو اليوم، السوريون أيضًا في ظروف صعبة، وإن كانت مختلفة، يبدؤون حوارًا جديدًا من أجل بناء النظام السياسي للدولة من جديد، بعد حقبة مظلمة انتهت بثورة استمرت لأكثر من 14 عامًا أطاحت بالحكم الدكتاتوري عسكريًا بعد أن دمّر البلاد.
كلفت قيادة العمليات العسكرية القائد أحمد الشرع برئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، بناء على الشرعية الثورية، ولقي هذا الإجراء تقبلًا واسعًا بوصفه إجراء ضرورة تمليه ظروف الفراغ القانوني، ووجد السوريون أنفسهم مرة أخرى أمام لحظة شبيهة بتأسيس الدولة نفسها، لكنهم هذه المرة أمام تأسيس نظام الدولة.
ولجعل مشاركتهم في تأسيس نظام الدولة ممكنة، أصدر الرئيس الشرع في 11 فبراير/ شباط 2025 قرارًا يقضي بـ “تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني”، مؤلفة من 7 أشخاص بينهم سيدتان، “مفوضة بوضع نظام داخلي لعملها”، وبـ “معايير” اختيارها لأعضاء المؤتمر، و”ينتهي عملها بصدور البيان الختامي للمؤتمر”.
صيغة المؤتمر
يشكل قرار تشكيل اللجنة أساسًا لفهم منظور السلطة الراهنة لدور لجنة الحوار، إذا يخلو القرار من قيود تحدد هدف اللجنة وجدول أعمالها وإطارها الزمني ومدى إلزامية مخرجات الحوار الذي ستقوده، وحدود التفويض الممنوح للحوار الوطني في الموضوعات التي سيناقشها، ويتفق هذا الإطار المفتوح الجوانب للجنة وللحوار الوطني ذاته مع التوجهات التي يذهب إليها العديد من الباحثين حول دور الحوار الوطني في الانتقال السياسي وآلية عمله، وهذا يعني أن القرار كان مدروسًا واستند إلى مشاورات وخبرات بحثية.
ويجب ملاحظة أن المؤتمر هو “مؤتمر حوار وطني” وليس “مؤتمرًا وطنيًا”، والفارق بين الصيغتين يكمن في الأهداف والتكوين، ففي حين يهدف المؤتمر الوطني إلى التمثيل الفعلي للقوى السياسية والاجتماعية لإصدار قرارات ملزمة، أو رسم سياسيات عامة للبلاد، يهدف مؤتمر الحوار الوطني إلى ترميم الشرعية للسلطات الجديدة القادمة بعد النزاعات، وبشكل خاص بعد الثورات.
وفي حين يأتي أعضاء المؤتمر الوطني في الغالب عبر انتخابات أو التوافقات بين القوى السياسية، فإنه في الحوار الوطني يكون بالتعيين، ولا توجد صيغ ثابتة ولا معايير دقيقة لاختيار المشاركين في الحوار، توجد تجارب عالمية لا يمتد عمرها إلى أكثر من ثلاثين عامًا يستأنس بها، لكن الأساس في الحوار، هو تحقيق أوسع نطاق لمشاركة المجتمع في تحديد مستقبل البلاد، وهذا ما يجعل نتائجه ملزمة للسلطة فيما هو محل توافق وإجماع وطني على الأقل، لأن تجاوزه سيكون مكلفًا في تآكل الشرعية، والغرض من المؤتمر أساسًا هو تعزيز الشرعية وترميمها.
اختيار الأعضاء
في حالات انتصار الثورات وسقوط النظام يظهر ميل مفاجئ وكبير للمشاركة في الهياكل السياسية، وهذه الاندفاعة التي حدثت في سوريا أيضًا الآن تضع ضغوطًا إضافية على اللجنة التحضيرية، وتزيد من صعوبة وضع قواعد مناسبة ومرضية للاختيار، خصوصًا أن الاختيار هنا غير تمثيلي بالمعنى التقليدي للكلمة، ولا توجد قواعد ثابتة في هذا المجال.
هناك فقط تجارب عديدة في العقود الثلاثة الأخيرة، ولكل منها طريقتها، لكن المبدأ أن تحقيق هدف الحوار يتطلب أوسع مشاركة ممكنة فيه، وكلما قلَّ عدد المشاركين في الحوار ضعف تأثيره في ترميم شرعية السلطة الجديدة القادمة عبر الشرعية الثورية.
هناك اقتراحات عدة حول عدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني، فهناك اقتراح اعتماد القاعدة في الانتخابات البرلمانية، حيث يكون هناك ممثل عن كل 100 ألف، ما يعني أن أعضاء المؤتمر يجب ألا يتجاوز عددهم الـ250 عضوًا، وإدارة حوار لمثل هذا العدد ممكن، لكنه باعتباره تعيينًا وليس انتخابًا، فإنه سيضعف قيمة نتائج الحوار، وسيكون هناك دائمًا خطر الحديث عن تحكم السلطة القائمة في النتائج عبر التعيين.
كان هنالك اقتراح أيضًا بـ1200 عضو، ولكن هذا الرقم يواجه صعوبة حقيقية في إدارة الحوار والوصول إلى نتائج، إذ من الصعب تصور إدارة حوار يضم مئات الأشخاص، إلا لو استخدمت تقنيات تكنولوجية لتسهيل التعبير عن الرأي، أو أدير الحوار على شكل ورش عمل متزامنة.
موضوع عدد المشاركين في المؤتمر يمثل تحديًا آخر، إلا أنه ذو طابع تقني مقارنة بالتحدي الأهم وهو معايير اختيار الأعضاء، إذ سيكون التحدي الرئيس للجنة، هل هو على أساس الدوائر الانتخابية التي تقوم على أساس جغرافي بطبيعة الحال، أم على أساس قوى المجتمع السوري المدنية وعلى رأسها النقابات والروابط المهنية والأحزاب والتيارات السياسية، أم على مزيج بينهما؟
التصريحات الرسمية المتكررة كانت تشير إلى التمثيل الفردي، أي العضو في المؤتمر بصفته ممثلًا عن نفسه، والواقع أن التمثيل الفردي يقلل من الطعن في شرعية المشاركين، لأنهم يشاركون بالنيابة عن أنفسهم، إلا أن هذا أيضًا يقلل من مدى تمثيل آراء المجتمع في الحوار، ومع ذلك يمكن تجاوز هذه العقبة من خلال اختيار يقوم على مبدأ “من” الجهة أو الشريحة وليس “عنها”؛ أي يأخذ بالاعتبار الانتماءات السياسية والمجتمع المدني والوجهاء المحليين والزعماء الدينيين والتكوينات العرقية والدينية، وشرائح المجتمع المختلفة، وقد أشار المتحدث باسم اللجنة التحضيرية إلى هذا الاعتبار.
وحيث إن اختيار اللجنة يقوم على أساس جغرافي، كما في توحي تصريحات صحفية عدة للجنة، التي أشارت إلى أن الحوار سيعقد في مختلف الجغرافيا السورية، فالواقع أن هذه خطوة مهمة، لأنها تعزز أهداف الحوار، إلا أنها لكي تكون كذلك يجب أن تكون معلنة للجمهور، كما أنها ستمثل آلية معقولة لاختيار العضوية لجلسات حوارية يشارك فيها كل السوريين.
ويتطلب نجاح الحوارات المحلية تحديد أهدافها مسبقًا على نحو واضح لدى اللجنة التحضيرية، والتي من المناسب في هذه الحالة أن تتمثل في الحصول على مقترحات وأفكار حول الموضوعات الرئيسية التي يجب أن يناقشها المؤتمر والتوجهات الرئيسية، والوصول إلى قائمة بالشخصيات الأكثر كفاءة وخبرة؛ تعبيرًا عن مصالح المجتمع وتطلعاته، فالحوارات وتحديد المصالح تحتاج شخصيات نوعية، وليس مجرد انتماء للمجتمع وتكويناته.
قد يكون تحديد أعضاء المؤتمر الجامع للسوريين في دمشق بـ 1200 ملائمًا حسب النتائج المتوقعة منه، لكنه بالتأكيد رقم كبير للوصول إلى نتائج تفصيلية أكثر وشاملة، لأنه من الصعب ضبط الحوار والوصول لنتائج، فكلما كبرت أعداد المشاركين ضعفت القدرة على ضبط الحوار والوصول إلى نتائج ملموسة.
لهذا يبدو من الضروري تحديد هدف المشاركين في مؤتمر بهذا الحجم، بألا يتجاوز مخرجات كثيرة، أهمها التوافق على بنود إعلان دستوري، وتشكيل هيئة تأسيسية، وهيئة تشريعية، وتشكيل هيئة التأسيسية يجب أن يكون منطقيًا يضمن حوارًا منتجًا، ويعبر عن مصالح وتطلعات السوريين، ويمكن أن يكون من 110 أعضاء، أي عضو واحد من كل عشرة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
مهمة الهيئة التأسيسية هي تشكيل دستور جديد، إذ توضع خلاصة الحوارات المناطقية بين يديها، بحيث يمكنها التفاوض والتوصل إلى تفاهمات عملية بين أطراف المجتمع، ولكن يمكن للهيئة التأسيسية أن تكون هيئة تشريعية برلمانية مؤقتة على غرار المؤتمر السوري العام عندما أعلن الدستور، وتحول إلى برلمان في أبريل/ نيسان 1920.
هذا ممكن بالطبع، وبالنظر إلى العدد الكبير لأعضاء المؤتمر، فإن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول لتشكيل اللجنة، وبالتالي يفترض أن تُصمم الانتخابات بحيث تقود إلى تمثيل مكونات المجتمع والمناطق بشكل متوازن.
المحاصصة المنبوذة
ينظر عادة إلى المجتمعات العربية والشرق أوسطية من خلال مكوناتها العرقية والإثنية، بوصفها مجتمعات متصارعة في حروب أهلية لا تتوقف منذ مئات السنين، وعلى هذا الأساس معظم الحلول التي تقدم للمنطقة هي أنظمة سياسية قائمة على المحاصصات الدينية والعرقية.
ومبدأ المحاصصات لم يتم العمل به في تاريخ سوريا منذ تأسيس الدولة؛ لأنه يقتل المواطنة ويشكل نظامًا معاقًا ذاتيًا، ويُنظر الآن في سوريا إلى الحالتين؛ اللبنانية والعراقية بصفتهما درسًا يجب ألا نخوضه مرة أخرى.
لهذا السبب هناك ميل سوري عام يتلاقى في رفض المحاصصة كأساس لنظام الدولة، عبّر عنه الرئيس الشرع مرارًا، وذكرته اللجنة التحضيرية في أول تصريحات رسمية لها، وهي بشكل عام تعكس القناعة السائدة لدى عموم السوريين.
لكن المجتمع السوري يضم عددًا من الأقليات الدينية، ومن غير الممكن ألا يكون هناك حوار وطني دون وجود أفراد يمثلون وجهة نظر ومصالح مثل هذه المكونات، فكيف يمكن الجمع بين نفي المحاصصة، وتمثيل تلك المكونات؟
لا يبدو أن هنالك حلًا مثاليًا في هذا الموضوع، لكن التمثيل الجغرافي الذي يضم بطبيعة الحال التكوينات المختلفة، يمكن أن يكون بديلًا للمحاصصة القائمة على مقاعد محددة، ويجب أن نتذكر هنا عند الحديث عن المحاصصة أننا نتحدث أيضًا عن العملية التي تؤدي إلى تحقيقها، وهي تضم المفاوضة على المقاعد، وعلى آلية العمل والاعتراض، إلى غير ذلك، ومع إلغاء المحاصصة، يصبح التمثيل في حدود الممكن والمعقول، وتتحرر اللجنة من العديد من الأعباء التي يمكن أن يفرضها نظام المحاصصة.
يقود موضوع المحاصصة والاختيار لأعضاء المؤتمر إلى سؤال أيضًا حول إمكانية وجود أطراف مستبعدة من المشاركة، مما قد يضر بالأهداف التي يتوخاها المؤتمر، مثل تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (SDF) الذي يقوده فعليًا حزب (PYD) الكردي التابع لحزب العمال الكردستاني، ولن يشارك في مؤتمر الحوار الوطني، أولًا لأنه حزب سياسي، والتمثيل في المؤتمر فردي، وثانيًا لأنه يحمل السلاح ضد السلطة المركزية، بحسب تصريح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ومع ذلك فإن عدم وجود هذا التنظيم، الذي حاول احتكار تمثيل الأكراد خلال العقد الأخير لا يعني عدم وجود المكون الكردي، ولا أعضاء من تلك التنظيمات في المؤتمر، فهؤلاء سيشاركون كغيرهم في المؤتمر بحسب تمثيل المناطق، كما أشارت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الأول في 12 فبراير/ شباط الجاري.
لكن الأهم والأصعب هو استبعاد مؤيدي النظام السابق مع الحفاظ على وجود العلويين في المؤتمر، فقد يكون في معيار إعلان معاداة الثورة خلال سِنِي كفاحها الطويلة، ما يساعد على وضعه في معايير العضوية للحفاظ على تمثيل معقول لمكونات الساحل، كما يمكن فهم هذا من عدة تصريحات لأعضاء اللجنة التحضيرية.
تكوين جدول أعمال
شُكلت اللجنة بدون جدول أعمال، وبدون تحديد إطار للنتائج، كما أشرنا، ولكن هدف اللجنة هو إدارة حوار وطني في كل ما يتعلق بمستقبل سوريا، ومن الصعب الاعتماد على الحوارات ذاتها لتشكيل جدول أعمال، فهذا سيضيّع الكثير من الوقت والجهد، لهذا تحتاج اللجنة التحضيرية وضع جدول رئيسي بالموضوعات، وتدير الحوار حولها، ولكن يتعين عليها بالتالي أن تبقى الموضوعات مرنة وقابلة للتطوير والتغيير مع إطلاق الحوار في مراحله المختلفة.
وفي هذا السياق، تصنيف الموضوعات على درجات حسب حساسيتها ودرجة الاختلاف حولها، ما يمنح الفريق ضبطًا للحوار، وتوجيهه بحيث يسهل الوصول إلى نتائج، فالمسائل المتعلقة بالدين وعلاقته بالدولة والأحوال الشخصية وهيكلية السلطة مثلًا يتوقع أن تشكل نقاشًا محمومًا، وغالبًا لا يكون بالإمكان حسم مثل هذه الملفات سوى في الهيئة التأسيسية، التي عليها أن تعد التوافقات النهائية بخصوص موادّ الدستور الدائم.
إدارة حوار وطني تأخذ وقتًا، ومن المحتمل أن تأخذ شهورًا، ومع ذلك كان بالإمكان تحديد جدول زمني واقعي لإنجاز المهمة، ولكن حتى يمكن اختصار الوقت فإن مثل هذا الحوار لا يدار بدون هياكل أساسية وفرعية، كما أنه يحتاج تشكيل فريق مساند من الخبراء يمكنهم تقديم المشورة التقنية، وإعداد ما يلزم لإطلاق الحوار، وتسريع العملية الحوارية وتحقيقها على وجه مناسب.
تشكيل هياكل مساعدة
وحسب الأسماء المعلنة في قرار تشيل اللجنة، فإن اللجنة مؤلفة من 7 أعضاء، وهم ينحدرون من 5 محافظات من أصل 14 محافظة سورية: دمشق، حلب، إدلب، حمص، دير الزور، والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن معرفة المرشحين المحتملين من المحافظات الأخرى لعضوية المؤتمر؟
هذا غير ممكن بدون وجود شخصيات خبيرة بكل محافظة، وهو أمر يقتضي وضعهم ضمن هيكلية إدارة الحوار، ولأنه لا يمكن لفرد امتلاك المعرفة الكافية بالمحافظة، فقد يكون من الضروري للوصول إلى الأشخاص المعنيين والواجب مشاركتهم في الحوار، تشكيلُ لجان فرعية للمناطق، فذلك ربما أفضل الطرق لتطبيق معايير اللجنة حول الأشخاص المرشحين.
الصعوبات المتعلقة بإدارة الحوار لا تتوقف هنا، فجمع النتائج وصياغتها يحتاجان لخبرات فنية، وقواعد محددة، وهذا تحديدًا يحتاج خبرات من نوع خاص، فالمسألة ليس مجرد تسجيل آلي للآراء، بل هناك طابع تقني تصمم له سجلات توثيق خاصة لتفي بالغرض من جهة، ومن جهة أخرى اتباع منهجية للصيغ تجمع الآراء دون التفريط بالفروق والاختلافات بينها سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح المؤتمر، ويقلل الكثير من الانتقادات المحتملة لمخرجات المؤتمر.
إدارة الحوار ذاتها تحتاج مهارات، ولها طرق وأساليب تسمح بتسهيل الوصول إلى توافقات مبكرة، وبالتالي يفترض أن يخضع مديرو الجلسات الحوارية أنفسهم لتدريبات خاصة من قبل خبراء متخصصين في إدارة التفاوض.
هذا أمر يمكن للأمم المتحدة أن توفره، وسبق أن قامت بتدريب العشرات من المعارضة السورية في عام 2013 وما بعده. فريق إدارة الحوار يقوم بمهام مختلفة عن فرق التنظيم والدعم التي يجب أن تشكل أيضًا. وجود مثل هذه الفرق يجب أن يكون من متطوعين بحيث توسع من شعور المجتمع بالمشاركة.
أخيرًا:
يشعر الكثيرون بأن إقامة “مؤتمر حوار وطني” يدعو للإحباط؛ لأنهم يعتقدون بأن نتائج المؤتمر غير ملزمة، ما يعني إفراغ التشاركية التي أرادت السلطة تحقيقها بالمؤتمر من مضمونها، بمعنى آخر تكريس الاستفراد بالحكم.
وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تبدو محقة من حيث المبدأ؛ إذ لا ضمانات في الالتزام بالنتائج، غير أن حاجة السلطة القادمة عبر الشرعية الثورية إلى تعزيز شرعيتها والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية والتجذر في المجتمع السوري وتحقيق الانتقال السياسي، ستكون الضامن الأهم لالتزامها بالتوافقات والقضايا المجمع عليها في مخرجات الحوار.
وبكل الأحول لا ينبغي توقع نتائج مثالية من هذا الحوار الوطني في عملية الانتقال السياسي، إنما ثمة ما يدعو للتفاؤل بأن الخطوة الأولى لمشاركة السوريين بتحديد مستقبل بلادهم قد بدأت للتوّ.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
أكاديمي وباحث متخصص في الحركات الإسلامية
الجزيرة
——————————
فرص تركيا التاريخية بعد الزلزال السوري/ د. سعيد الحاج
كاتب وباحث فلسطيني
18/2/2025
بات من المقطوع به أن التغير الجذري في سوريا ألقى بظلاله على المنطقة برمتها، وأن تركيا كانت في مقدمة الأطراف الخارجية المستفيدة من تغير النظام في دمشق. تتنوع المكاسب التركية بين السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، ولكن من بين الأهم بينها نفوذها الإقليمي وثقلها الإستراتيجي في المنطقة.
تركيا تتغير
جاء تغيير النظام في سوريا في توقيت مناسب جدًا لتركيا مما عظّم مكاسبها، لأسباب ذاتية وموضوعية، حيث كان سبقه عدة تطورات عالمية وإقليمية، فضلًا عن تغير مقاربة تركيا لسياستها الخارجية.
فمنذ تأسيس الجمهورية، بنت أنقرة سياستها الخارجية على فكرة الانكفاء على الداخل والتي تختصرها مقولة مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك “سلام في الوطن، سلام في العالم”. ولذلك حرصت لعقود طويلة على تجنب الانخراط في صراعات خارجية خوفًا من الاستدراج والاستنزاف، وكان التدخل لحماية القبارصة الأتراك في 1974 ضمن “عملية السلام” استثناءً يثبت هذه القاعدة بالنظر إلى أنها لا تنظر لقبرص كقضية “خارجية” وإنما “الوطن الصغير” أو “الوطن الابن”.
المفارقة أن تداعيات الثورة السورية في سنواتها اللاحقة كانت ضمن أهم الأسباب التي دفعت تركيا لتغيير فلسفة سياستها الخارجية والتحول من الاعتماد حصرًا على القوة الناعمة نحو بعض أدوات القوة الخشنة، فكانت “درع الفرات” في 2016 العملية الأولى التي دشنت سردية “التدخل الحمائي” أو الدفاعي بدل سردية “تجنب الغرق في المستنقع السوري”. ثم تبعها عمليات عسكرية عديدة في سعي لتقويض إمكانات تشكيل كيان سياسي لمنظمات ترتبط بالعمال الكردستاني، وبالتالي تراه تركيا “ممرًا إرهابيًا” على حدودها.
قضت النظرية العسكرية والأمنية الجديدة بانتهاج الحرب الاستباقية و”تجفيف منابع الإرهاب في مصادره”، كما دفعت لعمليات عسكرية متقدمة في عمق الأراضي العراقية ضد معاقل الكردستاني، وإنشاء قواعد عسكرية في العراق وقطر والصومال، والتدخل في نزاعات إقليمية كما في ليبيا وجنوب القوقاز، إضافة لتطوير الصناعات الدفاعية، وخاصة قطاع المسيّرات بحيث أصبحت الصناعة المحلية الركن الرئيس في تسليح الجيش التركي، وأدخلت تركيا نادي الدول المصدرة للسلاح.
تطورات إقليمية ودولية
عظّم ذلك الثقل الجيوسياسي لتركيا في المنطقة، ولكن تثمير ذلك سياسيًا وكنفوذ بقي محدودًا؛ بسبب علاقات أنقرة المتراجعة مع عدد من القوى الإقليمية، وقد كان ذلك ضمن عدة أسباب دفعت لتهدئة مسارات السياسة الخارجية، وتحسين العلاقات مع الأطراف المذكورة ابتداءً من 2021، وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومصر.
كما أن توتر علاقات أنقرة بعدد من القوى الغربية ونزوعها نحو استقلال نسبي في سياستها الخارجية، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وملف طلب عضوية الاتحاد الأوروبي، عرّضاها لانتقادات غربية وتعالت بعض الأصوات المتطرفة المطالبة بإخراجها من الناتو.
وفي الملف السوري، أحد أهم ساحات التنافس الجيوسياسي الإقليمي، بقيت أنقرة في موقف دفاعي بعد هدوء الأوضاع الميدانية، فتم بالتدريج تصفية مناطق خفض التصعيد من أربعة لواحدة، بل وفككت تركيا نفسها بعض نقاط مراقبتها وفق اتفاق سوتشي؛ بسبب حصار النظام لها.
جاء متغيران مهمان غيّرا هذه المعادلات بدرجة كبيرة. أولهما الحرب الروسية – الأوكرانية التي أكدت أهمية تركيا بالنسبة للغرب، فهي جارة لهما من البحر، وقادرة على التواصل مع كلتيهما، فضلًا عن سيطرتها على المضايق. كما أن الحرب أعادت تعريف التهديدات لأوروبا ودور تركيا في مواجهتها، وهو ما ذكره أكثر من مسؤول غربي صراحة، كما ورد على لسان رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس خلال لقائه بأردوغان.
ثم جاءت معركة “طوفان الأقصى” التي قلبت المعادلات في المنطقة، ابتداءً بتقويضها للعقيدة الأمنية “الإسرائيلية” بمختلف ركائزها، مرورًا بتمددها في المنطقة، وخصوصًا توسيع “إسرائيل” لمناطق احتلالها في سوريا وتهديدها بمهاجمة إيران، وهو ما عدّته أنقرة تهديدًا للاستقرار الإقليمي، ولها بشكل مباشر، وليس انتهاءً بتغير توازن القوى الإقليمي.
سوريا: فرص ومخاطر
في سياق المتغيرات سالفة الذكر، وفي ظل الاستعصاء في الملف السوري الذي دفع أردوغان لعرض تطبيع العلاقات على الأسد، جاءت “ردع العدوان” التي أسقطت النظام وأدت لانقلاب كبير في توازنات الملف السوري والمنطقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالثلاثي التركي – الروسي – الإيراني.
فقد أتى نظام صديق لتركيا عكس السابق، وتعوّل أنقرة على تعاون اقتصادي وتجاري وفي ملف إعادة الإعمار مع دمشق، وعلى دور مهم تلعبه في إعادة هيكلة المؤسسات السورية ولا سيما العسكرية والأمنية، وتستشرف فرصة تاريخية لإنهاء ملف العمال الكردستاني داخليًا وفي سوريا، وباتت الطرف الأكثر قربًا في المواقف والتوجهات مع سوريا الجديدة وبمثابة المظلة الإقليمية لها.
في المقابل، انكفأت روسيا في سوريا نحو قواعدها العسكرية بعد أن كانت صاحبة النفوذ الأكبر فيها، ولا سيما في ظل انشغالها بالحرب في أوكرانيا، وتثار علامات استفهام حول مستقبل هذه القواعد والتي تتجاوز أهميتها الجغرافيا السورية بعدِّها بوابة للوجود الروسي في ليبيا ثم عمق القارة الأفريقية، ما يعني أنها مفتاح مهم للنفوذ الروسي في المنطقة والعالم.
أما إيران فخرجت بشكل شبه كامل من الملف السوري، وتواجه سياسة دولية – إقليمية بمحاصرتها وتقليم أظفارها في الإقليم، متمثلة بسياسة الضغط الأقصى التي يبدو أن ترامب سيعود لها، وتهديدات نتنياهو المستمرة بمهاجمة مشروعها النووي لـ “استكمال المهمة”، فضلًا عن الضغوط على حلفائها وشركائها في كل من لبنان والعراق.
يعني ذلك علو يد أنقرة على كل من موسكو وطهران (وغيرهما) في الملف السوري، وهو أمر سيكون له تأثيره وتداعياته على عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لهذه الدول، وفي مقدمتها ليبيا والقوقاز وآسيا الوسطى والبحر الأسود والبلقان وربما العراق.
كما أن احتمال ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا يقوي أوراق الأخيرة في مواجهة التحالف الذي تقوده غريمتها اليونان بخصوص ثروات شرق المتوسط، لا سيما مع الاتفاق مع ليبيا في 2019 وتحسن العلاقات مع مصر مؤخرًا.
وأخيرًا، فإن كل ما سبق يعزز أوراق القوة التركية في العلاقات مع إدارة ترامب، وخصوصًا فيما يرتبط بالوجود الأميركي العسكري في سوريا ودعم قسد، وهو ما رشحت بشأنه تصريحات تشير إلى عودة ترامب لفكرة سحب قوات بلاده أو على الأقل تخفيفها، وهو عنصر قوة كبير جدًا لتركيا التي تضع ملف قسد في رأس أولوياتها.
يعني كل ما سبق أن أنقرة اليوم مع الزلزال السوري الأخير في ذروة نفوذها الإقليمي وموقعها في التنافس الجيوسياسي مع مختلف اللاعبين في المنطقة، وأنها أمام فرصة تاريخية لتأسيس أمر واقع يبنى عليه معطيات تستمر لعقود قادمة إن كان في سوريا عمومًا أو ما يرتبط بملف العمال الكردستاني على وجه الخصوص.
لكنها ليست طريقًا مفروشة بالورود، بل تكتنفها تحديات كبيرة ومخاطر ليست بالسهلة. فرغم أن أنقرة قدمت رسائل طمأنة ضمنية لمختلف الأطراف بعدم التفرد في سوريا، وهو ما أكده وزير خارجيتها هاكان فيدان في ميونخ بشكل صريح، فإن توجس بعض القوى الإقليمية منها ليس خافيًا.
بعض التصريحات الرسمية وغير الرسمية في كل من موسكو وطهران في أول أيام “ردع العدوان” تضمنت اتهامات بـ “الخداع والخيانة”، وشخص مثل ألكسندر دوغين هدد أردوغان بـ “دفع ثمن” ما حصل لروسيا في سوريا.
كما أن ملف قسد ليست له نهاية واحدة محتملة فقط، رغم تعزز أوراق تركيا وتوافق القيادة السورية الجديدة معها في توحيد الأراضي والمؤسسات السورية، ذلك أن دمشق لا تبدو في عجلة من أمرها لإنهاء الملف، وترامب غير مضمون المواقف والتوجهات، ما يترك الملف معلقًا في المرحلة الحالية على أهميته وحساسيته بالنسبة لأنقرة.
ويبرز الاحتلال “الإسرائيلي” كمهدد كبير لتركيا وسوريا معًا، إذ يحرض ضد قيادة الأخيرة، ويرجّح سيناريوهات التقسيم، ويتواصل مع قسد وغيرها من “حلفائه الطبيعيين” كما يدعي، بعد أن قوّض الكثير من إمكانات الدولة السورية ووسع احتلاله لأراضيها، ما جعله على حدود تركيا عمليًا ومهددًا مباشرًا لها.
يضاف لذلك تقرير لجنة “ناجل” التي أوصت بالاستعداد لإمكانية المواجهة العسكرية مع تركيا بعد سنوات، فضلًا عن أن موقف “إسرائيل” قد يكون مدخلًا لتغيير الموقف الأميركي من أنقرة.
وختامًا، فإن المكاسب الكثيرة والكبيرة لتركيا رهن باستقرار الأوضاع في سوريا ونجاحها في اجتياز المرحلة الانتقالية، بينما قد يرتد أي تعثر أو فشل أو فوضى أو تدخل خارجي على تركيا بشكل سلبي، بعد أن اندفعت بشكل كلي خلف الحالة الجديدة في سوريا. ولذلك كان خطاب تركيا وممارستها وتوجهاتها هادئة وحذرة وإيجابية تجاه مختلف الأطراف، في سعي لإنجاح المسار من جهة، وتقليل تداعيات أي تعثر فيه من جهة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث فلسطيني
الجزيرة
——————————————
الاتحادات الرياضية السورية: إعادة هيكلة للمؤسّسات البعثية/ محي الدين عمّورة
ترتيب البيت الداخلي وترتيب العلاقات مع المؤسسات الدولية التي تُعطي الشرعية
18-02-2025
لم تكن الرياضة يوماً حدثاً ثانوياً في حياة الشعب السوري منذ مئة عام تقريباً حتى اليوم، رغم ما مرَ على هذه البلاد من تحديات وظروف مختلفة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية.
في أوائل القرن الماضي ظهرت لعبة كرة القدم في سورية وهي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويعتبر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم من أقدم الاتحادات في المنطقة حيث تأسس عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1969، وكذلك الحال بالنسبة لكرة السلة التي يعتبر اتحادها من أقدم الاتحادات في المنطقة أيضاً، حيث انضم إلى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة السلة عام 1948.
قبل وبعد هاتين اللعبتين ظهرت الكثير من الألعاب، وتأسس لها اتحادات، وكان لكرة القدم والسلة وبقية الألعاب مشاركات عربية وقارية ودولية. وبقيت كل الألعاب حرة طليقة تمثل الرياضة فقط، حتى عام 1971، عندما ظهر الاتحاد الرياضي العام، وهو منظمة تتبع لحزب البعث، حاله حال بقية المنظمات والاتحادات والنقابات. عندما نقول حزب البعث، لا يتبادر إلى ذهن المواطن السوري سوى الفساد والخراب والسرقات والمحسوبيات، وهذا ما حدث في منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي وضعت يدها على كل الرياضة في سورية، ويكفي القول إن أموال الرياضة جميعها كانت تذهب لهذه المنظمة، وهي التي تنفق على كل الاتحادات والألعاب داخلياً وخارجياً، والمعنية ببناء وصيانة كافة الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية، والمسؤولة عن كل الاستثمارات، حتى نعرف حجم الفساد.
أصبحت الرياضة في مختلف دول العالم مصدر دخل كبير، وأصبح الاستثمار في القطاعات الرياضية يحتل صدارة الاستثمارات، بل إن عائدات الرياضة أصبحت تدخل في ميزانيات بعض الدول، فيما تنافس ميزانيات بعض الأندية حول العالم ميزانيات دول وتتفوق عليها في بعض الأحيان. لكنه في سورية لم يكن يوماً كذلك، بل كان منفعةً شخصية لأصحاب القرار والمستثمرين المتعاملين معهم، على حساب تطور الرياضة في كل الألعاب وتحقيق النتائج في أي مشاركة خارجية. كل الرياضيين في كل الألعاب الفردية والجماعية تبدأ رحلتهم من الأندية، لكن الأندية في سورية تعيش ظروفاً مادية سيئة منذ عشرات السنوات، وهو ما انعكس سلباً على الأداء والنتائج. معظم الأندية في سورية ليس لديها استثمارات تُدرُّ عليها المال، وحتى الأندية التي لديها استثمارات هي رهينة لفساد إداراتها المتعاقبة مع المستثمرين وفروع الاتحاد الرياضي العام في كل المحافظات، بتغطية ومباركة من المكتب التنفيذي للاتحاد.
لماذا هذه المقدمة؟ لنقول إن أول ما فعلته الحكومة الجديدة في سورية بعد إسقاط نظام الأسد هو تعيين رئيس جديد للاتحاد الرياضي العام، هو محمد الحامض الذي تسلّم رئاسة الاتحاد الرياضي العام بعد استقالة فراس معلا، وفق ما نُشر على صفحة الاتحاد على فيسبوك بتاريخ السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر). وفي التاريخ نفسه نشرت الصفحة خبراً يقول: «رئيس الاتحاد الرياضي العام الأستاذ محمد الحامض: أجرينا جولات على المنشآت الرياضية في منطقتي البرامكة والفيحاء، وتفقدنا الحالة الفنية للملاعب المختلفة، كما اطلعنا على الموجودات فيها». وخبرٍ آخر: «رئيس الاتحاد الرياضي العام: اتصلنا بعدد من الخبراء الرياضيين السوريين المقيمين في الخارج، لبحث إمكانية الاستفادة منهم الآن وفي المستقبل». وفي خبرٍ رابع: «محمد الحامض: عقدنا جلسات مع الكوادر الرياضية الموجودة في مدينة دمشق للتحدث عن الواقع الرياضي في عهد النظام المخلوع والتحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة».
في اليوم التالي كان هناك حديث مطول لرئيس الاتحاد الجديد، كشف فيه عن خططٍ من أجل تطوير الرياضة السورية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة الاتحاد الرياضي. كما تحدث عن الاستثمارات الرياضية التي لم تكن تُدار بطريقة صحيحة وإنما وفق المحسوبيات، حسب قوله. كما تحدث عن إعادة تأهيل ملعب العباسيين التاريخي وغيره من الملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى. اللافت للنظر وجود أشخاص يعملون في المكتب التنفيذي ولهم مناصب، مثل اسماعيل مصطفى نائب رئيس الاتحاد ومدير مكتب التنظيم، وفراس تيت عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الألعاب الجماعية وأشخاص آخرين، لكن كل ذلك بشكل غير رسمي ولم يصدر أي كتاب يؤكد عضوية هؤلاء الأشخاص ضمن الاتحاد، ولا حتى على صفحة الاتحاد نفسه، باستثناء الأخبار التي تنتشر على وسائل الإعلام بأسماء هؤلاء الأشخاص ومسمياتهم الوظيفية.
لجان مؤقتة في المحافظات
بتاريخ الثالث عشر من كانون الأول (يناير) الماضي، بدأ المكتب التنفيذي بتكليف لجان مؤقتة لتسيير أمور اللجان التنفيذية في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب ودير الزور واللاذقية والقنيطرة، وبعدها بيومين في حمص وحماة وإدلب، وفي 30/1 في دمشق، وتأخر الإعلان عن لجنتي طرطوس والسويداء حتى تاريخ 13/2. طبعاً مع صدور كل لجنة كانت هناك أصوات تتعالى ضد بعض الأسماء بسبب تاريخها، وخاصةً لجهة ارتباطها بنظام الأسد المخلوع، وأسباب أخرى تتعلق بالخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل الإداري الذي يشمل الإشراف على الأندية والمنشآت في كل محافظة. في لجنة محافظة حمص مثلاً، نُشرت على صفحة الاتحاد أسماء اللجنة برئاسة عمار الفرا بتاريخ 15/1 ، وبتاريخ 30/1 نُشر خبرٌ آخر يقول: «المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ينهي مهمة السيد صلاح مغربي من رئاسة اللجنة التنفيذية المؤقتة بحمص ويكلف السيد أيمن أبو غليون بدلاً منه». ويعود السبب إلى أن أصوات الرياضيين في حمص ارتفعت ضد عمار الفرا بسبب قولهم إنه «بعثي وتاريخه لا يسمح له أن يتواجد في مثل هذا المنصب». وبالفعل استجاب الاتحاد للأصوات وكلّف بدلاً منه صلاح مغربي قبل أن تتم إقالة الأخير بسبب ما قيل إنه «تجاوز العمل المؤسساتي والجماعي وتفرّد بالقرار وفرض المهام على بقية أعضاء المكتب».
في طرطوس، ومع إعلان اسم الدكتور وائل معوّض كرئيس للجنة، تداول الناشطون عدداً من المنشورات السابقة له يمدح ويمجد فيها نظام الأسد، ويقول الناشطون إنه كان مسؤولاً عن تنظيم مهرجانات واحتفالات لمؤسسات تابعة لأسماء الأسد ومنال الأسد. وبعد 4 أيام فقط نشر الاتحاد قراراً باعتذار معوّض، بناءً على طلبه كما جاء في القرار، وتم تكليف معاوية أحمد عادل حمامي بدلاً منه. وفي دير الزور حدث أمر مشابه بحق أحد الأعضاء. أما في دمشق، وبعد إعلان أسماء اللجنة المكونة من رئيس و6 أعضاء، أيضاً خرجت أصوات تسأل «كيف للجنة غالبية أعضائها ليسوا من أبناء دمشق أن تدير أمور محافظة دمشق وأين أبناء المحافظة من هذه اللجنة». هذه بعض النماذج لما حدث في مسألة تشكيل اللجان التنفيذية المؤقتة في المحافظات.
اليوم يتساءل الشارع الرياضي عن عملية اختيار هذه الأسماء، خاصة أن هذه اللجان ربما يكون لها دور مؤثر في الترشيح للانتخابات التي ستجري لاحقاً على جميع المستويات. ويقول المتابعون للشأن الرياضي إن فروع الاتحاد الرياضي العام سابقاً لم يكن دورها مهماً في مسيرة الرياضة السورية، بل كان وجودها مضيعةً للوقت. على العموم، ذكر نائب رئيس الاتحاد اسماعيل مصطفى أكثر من مرة أمام المقربين منه أن هذه اللجان ليست مقدسة، وأن أي أسم يكون حوله اعتراضٌ ما سيقوم الاتحاد بتغييره فوراً.
بعد انتهائه من تكليف اللجان المؤقتة في بعض المحافظات، تحول الاتحاد بإدارته الجديدة نحو الأندية، حيث أصدر قراراً بتاريخ 29/1/2025 نشره على صفحته جاء فيه: «قرّر الاتحاد الرياضي العام حل جميع إدارات الأندية الرياضية في سورية وتوجيه اللجان التنفيذية في المحافظات بالإشراف على الأندية ريثما يتم رفع مقترح بتشكيل إدارات جديدة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي، وبأسرع وقت ممكن. ويأتي هذا القرار بناء على ما تحقق من نصر عظيم وتحرير سورية من النظام البائد ونظراً لتدخل السلطات السياسية في الانتخابات الرياضية بشكل عام وثبوت تدخل حزب البعث الفاسد بتوجيه النتائج وفق مصالحه».
مَن يتابع الرياضة في سورية يعلم أن سنة 2024 شهدت أغرب انتخاباتٍ في تاريخ إدارات الأندية في سورية، وخاصةً الأندية الجماهيرية الكبيرة. عادةً ما كانت تشتعل المنافسة والصراعات في الانتخابات، لكن الانتخابات الأخيرة شهدت لأول مرة حالةً من العزوف والتهرّب من خوضها. معظم إدارات الأندية تم انتخابها بالتزكية لعدم وجود منافس، والبعض منها تم تعيينها من قبل اللجان التنفيذية في المحافظات نظراً لعدم ترشّح أحد، وحتى بعد التعيين كان هناك اعتذارات لأكثر من مرة للإدارات المُعيّنة. لأول مرة يحاول الجميع التهرب من تحمل مسؤولية أي نادي، والسبب الأول والأخير هو المال. لذلك فإن هذه الإدارات في معظمها لم تأت نتيجة انتخابات تنافسية. وكانت إدارات الأندية في السنوات الأخيرة شهدت حالة من الفوضى والفساد، حيث دخلت شخصيات عدة بعيدة عن الرياضة، مثّلت بمعظمها أذرع أمنية وميليشيوية وسياسية وإعلامية واقتصادية للنظام البائد، طمعاً في مكاسب مالية وشعبية على حساب الجانب الرياضي.
التوجه الآخر من قبل الاتحاد الرياضي العام كان نحو اتحادات الألعاب. في سورية هناك رياضتان فقط دخل نظام الاحتراف إليهما، وهما كرة القدم وكرة السلة. لذلك تجد الأنظار موجهة دائماً نحو هاتين اللعبتين، وهما الأهم والأكثر شعبيةً ومتابعةً جماهيرية.
اتحادات كرة القدم والسلة
بتاريخ 24/12/2024 تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم باستقالتهم بشكلٍ رسمي، وتم تكليف الأمين العام محمد مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد استناداً لما نصت عليه أحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي السوري لكرة القدم. في حين أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عن انتهاء ولايته بشكل رسمي بتاريخ 31/12/2024، وبعد يومين تم تكليف لجنة مؤقتة مؤلفة من رئيس و4 أعضاء لتسيير شؤون الاتحاد حتى موعد الانتخابات القادمة.
وتحظى كرة القدم بخصوصية في كل دول العالم، حيث تحظى الاتحادات الوطنية بحماية ووصاية من الاتحادات القارية والاتحاد الدولي، ويشرف الاتحاد الدولي على النظام الداخلي لأي اتحاد وطني، كما يشرف على الانتخابات ويمنع أي تدخل للسلطات في أي بلد بعمل الاتحادات الوطنية، تحت تهديد تجميد العضوية وإيقاف النشاطات الرياضية والمشاركات الخارجية، كما حدث في الكثير من دول العالم. وحاول البعض للترويج لفكرة وجود لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد، إلا أن الاتحادين الآسيوي والدولي رفضا الفكرة وأصرّا على بقاء الأمور بيد الأمين العام للاتحاد، وذلك وفقاً للنظام الداخلي للاتحاد السوري لكرة القدم. وقبل أيام قليلة ظهرت فكرة جديدة، وهي «لجنة تطبيعية». صحيفة الثورة حاورت الدكتور فراس المصطفى المستشار القانوني ومسؤول النزاهة والامتثال في الاتحاد السوري لكرة القدم، والذي أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يوافق حتى الآن على المساعي التي بذلتها بعض الأطراف خارج سوريا لتشكيل لجنة تطبيعية تتولى إدارة شؤون الاتحاد. وأضاف الدكتور المصطفى أن الترويج لفكرة تشكيل لجنة تطبيعية لم يكن بدافع الإصلاح كما يدّعي البعض، بل جاء نتيجة أهداف مادية بحتة، حيث إن العمل في مثل هذه اللجان يكون مقابل تعويضات مالية تقدر بآلاف الدولارات. وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد، حسب قناعته، تشكيل لجنة استشارية لدعم العمل الكبير الذي تضطلع به الهيئة التشغيلية للاتحاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لثقة الفيفا بالجهات التي تتولى إدارة الشؤون اليومية للاتحاد، وليس انتقاصاً من الجهود المبذولة. وفعلاً بتاريخ 14/1 تم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة على صفحة اتحاد كرة القدم والتي ضمت عدداً من الرياضين السابقين، مؤلفةً من رئيس و4 أعضاء. ثم أصدرت الأمانة العامة تعميماً آخر جاء فيه جملة من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة حسب وصف التعميم، أولها وأهمها استئناف النشاط الرياضي الكروي المحلي على مستوى جميع الفئات والدرجات بتاريخ 10/4/2025، ومجموعة قرارات أخرى تتعلق بالمنتخبات الوطنية بجميع الفئات والمدربين والحكام والجوانب الإدارية والتنظيمية.
في كرة السلة كان الموضوع مختلفاً، حيث أن الاتحاد السابق انتهت ولايته رسمياً مع نهاية عام 2024، لذلك قام الاتحاد الرياضي العام في بداية العام الجديد بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة، وتألفت اللجنة من رئيس و4 أعضاء.
بقية الاتحادات الرياضية
وفي بقية الاتحادات كان هناك استقالة لعضوين من مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو والبولينغ، وقد وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على الاستقالة وأعاد ترميم المجلس بأعضاء جدد. كما قام الاتحاد بإعادة تشكيل مجالس الإدارة في اتحادات الكاراتيه والقوة البدنية وبناء الأجسام. ويقول نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام اسماعيل مصطفى إن المكتب التنفيذي ليس في عجلةٍ من أمره لتغيير كل اتحادات الألعاب، إلا عند الضرورة، وهي وجود مشاركات خارجية لمنتخبٍ ما في اتحادٍ ما. طبعاً هذا الكلام لم يعجب الرياضيين ولا المتابعين، لأن هناك اتحادات تسبّب القائمون عليها بـ«دمار لتلك الألعاب» حسب وصفهم، فهي في معظمها متوقّفة عن المشاركات الخارجية منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن هناك ألعاب حتى على المستوى المحلي لم يعد لها أي نشاط، وحتى المشاركات الخارجية لبعض الألعاب كان يشوبها الفساد والمحسوبيات واستبعاد لأسماء ناجحة وقادرة على تحقيق النتائج بسبب انتقادها لعمل اتحاد ما أو لجنة فنية أو لجنة تنفيذية أو للمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. وعادةً ما كانت المشاركات الخارجية لمعظم الألعاب فرصةً للكثيرين للسياحة والحصول على المال، لذلك كنا نجد الكثير من الأسماء التي ليس لها علاقة بالرياضة تسافر ضمن البعثات، وكثيراً ما كانت أسماء الإداريين أكثر من أسماء اللاعبين المشاركين بأضعاف، ولنا في المشاركات السورية في دورات الألعاب الأولمبية خير دليل على ذلك. يقول أحد الأكاديميين الرياضيين في لعبة الجمباز للجمهورية.نت (فضّل عدم الكشف عن اسمه): «تقود اتحاد لعبة الجمباز لجنة مؤقتة تم تعيينها في عهد النظام البائد، وما زالت تمارس عملها بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يحدث، حتى أنها أقامت مهرجاناً في دمشق بمناسبة التحرير، حضره رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بدمشق وأعضاء اتحاد الجمباز، وأن من قام بالتحضير لهذا المهرجان كان مساعد أول في المخابرات الجوية في حرستا»، حسب قوله.
التحديات كبيرة
لا شك أن حجم التحديات الذي يقع على عاتق الإدارة الرياضية الجديدة كبير جداً، فهو حصاد أكثر من خمسين عاماً من الفساد. وتكمن المشكلة في ترابط الملفات ببعضها البعض، من انتخابات إدارات الأندية وإدارات اتحادات الألعاب إلى عودة النشاط الرياضي واستئناف البطولات المحلية مع أو بدون أندية الشمال المُحرّر سابقاً، إلى المنشآت والملاعب المدمرة، عدا عن الاستثمارات وما فيها من خلل كبير، ثم العقوبات المفروضة على الرياضة السورية، ومنها الأموال المجمدة خارجياً والتي تُقدر بملايين الدولارات. كل هذه المشاكل تدفع البعض للسؤال: أليس الأجدى أن يكون هناك هيئة مستقلة للرياضة بعيداً عن فكرة الاتحاد الرياضي العام الذي هو من مخلفات حزب البعث، خاصةً وأن حفل تنصيب أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً للبلاد شمل الإعلان عن حل حزب البعث. في المقابل يرى البعض أن فكرة التخلي عن وجود منظمة الاتحاد الرياضي العام لن يلقى القبول عند الكثيرين، والسبب الواضح أن معظم الرياضيين والمسؤولين عن الرياضة ليس لديهم شهادات علمية، ما يعني أنهم غير قادرين على تسلّم المناصب في هيئة مسؤولة عن الرياضة، وأن بقاء الاتحاد الرياضي العام سيظل يؤمّن مئات وربما آلاف الوظائف في الاتحادات واللجان وإدارات الأندية وإدارات المنشآت الرياضية المختلفة.
موقع الجمهورية
——————————–
فن «غير الممكن»: كيف يُعيد المسرحُ التفكيرَ بسؤال العدالة في سوريا؟/ وسيم الشرقي
18-02-2025
منذ الأيّام الأولى لهروب الأسد، يتداول سوريّون وسوريات على مختلف وسائل التواصل فيديو قصيراً لأحمد الشرع، جالساً في الصفّ الأوّل لمسرح في مدينة إدلب، يتابع المشهد الأخير من مسرحيّة يتلو أحد ممثلّيها حُلماً رأى فيه أنّه مذيع إخباري يزفّ خبر تحرير مدينة دمشق بالكامل، ويهنئ فيه شعب سوريا العظيم بتحرير «دمشق الروح، دمشق القلب، دمشق الياسمين، دمشق الفيحاء…». على وقع هذه الكلمات تدمعُ عينا الشرع، ويمدّ يده ليلتقط منديلاً ليمسح دموعه.
الفيديو الذي انتشر كثيراً عقب التحرير الحقيقي لدمشق، يعود لمسرحيّة قصيرة عُرِضت في افتتاح الدورة الثالثة من معرض إدلب للكتاب في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، في المشهد الذي يُعرَض على الخشبة، يدور حوار في مخيّم لللاجئين السوريّين بين شابّين، الأوّل يُقرّر العودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في دمشق، بعد سنوات من العيش في المُخيّم، أما الشاب الآخر، والذي يَظهر بثياب ممزقّة وحالة بائسة، وقد وصل للتو من مناطق سيطرة النظام، يُستَفزُّ حين يسمع بقرار الشاب الأوّل، ليدخل الاثنان في حوار غاضب عن طبيعة الحياة في مناطق سيطرة النظام وضرورة الصبر حتّى إسقاطه، ليتدخّل الممثّل/المذيع ويُنهي المسرحيّة بالخطاب الذي أبكى الشرع يومها.
قُبيل نهاية العام الماضي، وفي مقابلته الأولى مع محطّة عربيّة، يُجيب الشرع عن سؤال المذيع حول إمكانيّة حضوره لـ«مسرحيّة ملتزمة تنتقده» بأنّه الآن «لا يجد الوقت للنوم»، وبإنّه سيستغلّ الوقت إن وُجِد بالراحة، لينتشر هذا الجزء من المقابلة مثل الفيديو القديم من معرض إدلب للكتاب، ويتحول إلى عنوان للاستوديو التحليلي حول كلام الشرع على قناة العربية، وإلى موضوع لردٍّ من عميد المعهد العالي للفنون المسرحيّة بدمشق، يقول فيه إن التفاعل الواجب مع كلام الشرع هو دعوته لحضور مسرحيّات في المعهد.
في كلتا اللحظتين، لحظة معرض إدلب للكتاب، ومقابلة قناة العربيّة، يحمل المسرح رمزيّة معيّنة؛ الأولى تتعلّق بتفاؤل مُهجَّري وأهل إدلب بتحرير سوريا رغم التشاؤم الذي كان سائداً وقتها، والثانية تتعلّق بالطبيعة المحتملة للحكم الجديد في دمشق، خاصّة فيما يتعلّق بالفنون والثقافة، وذلك وسط تخوّفات من قيود محتملة للحكّام الجدد على القطّاع الفنّي، وغياب الوضوح حول رؤية الإدارة الحاليّة للفن ومؤسساته في سوريا.
ولكن ماذا لو ابتعدنا قليلاً عن دموع الشرع في إدلب عند ذكر دمشق الياسمين، وعن ابتسامته الدبلوماسيّة المُتعَبة في قصر الشعب في دمشق حين سؤاله عن المسرح، وسألنا كيف يمكن تَخيُّل شكل المسرح السوري في سوريا ما بعد الأسد؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الفن السهل الممتنع في سوريا الجديدة؟
«ميزةُ المسرح التي تجعله مكاناً لا يُضاهى، هي أن المتفرِّج يكسرُ فيه مَحّارته، كي يتأمل الشرط الإنساني في سياق جماعي يوقظ انتماءه إلى الجماعة، ويُعلَّمه غنى الحوار وتَعدُّد مستوياته. فهناك حوار يتم داخل العرض المسرحي، وهناك حوار مُضمَرٌ بين العرض والمتفرج. وهناك حوار ثالث بين المتفرجين أنفسهم. وفي مستوى أبعد، هناك حوار بين الاحتفال المسرحي، عَرضاً وجمهوراً، وبين المدينة التي يتم فيها هذا الاحتفال. وفي كل مستوى من مستويات الحوار هذه ننعتقُ من كآبة وحدتنا، ونزداد إحساساً ووعياً بجماعيّتنا. ومن هنا، فإن المسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني فحسب، بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع، وضرورة من ضرورات نموه وازدهاره».
في رسالته في يوم المسرح العالمي قبل قرابة الثلاثين عاماً، يحلم الكاتب المسرحي السوري الراحل سعد الله ونوّس بدورٍ للمسرح في حياة مجتمعاتنا المعاصرة، يُعزِّز فيها هذا الأخير دور الحوار، الحوار المركّب والمتعدّد. ورغم كتابة ونّوس للكلمة أثناء مقاومته لمرض السرطان، ورغم وعيه يومها بالحال البائسة التي وصل إليها المسرح قُبيل نهاية القرن الماضي، وبأَخطار «الشاشات الملوّنة والتفاهات المعلّبة»، يؤكد في جملته الشهيرة على أنّنا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ.
في الأسابيع الأخيرة عُدنا كسوريّين للتذكّر بأنّنا فعلاً محكومون بالأمل، وأنّ حُكْمَ الأبد لم يكن نهاية التاريخ، لكن ما الذي يمكن فعله اليوم بالإضافة إلى التحلّي بالأمل القادر على إحياء القدرة على العمل، وأيّ دور يمكن أن يلعبه المسرح في سوريا اليوم؟
المسرح والعدالة
حديثُ المسرح ذو شجون، سواء كان مع مُخرِجة مسرحيّة في برلين أو كاتب مسرحي في نيويورك، وخاصّة في لحظتنا الحاليّة، وسط تراجع الاهتمام بالفنون حتّى في أكثر دول العالم غنى، وصعود كبير لحكومات يمينيّة تُقلِّص تمويل الفنون وعلى رأسها المسرح.
وبطبيعة الحال، فالأمر أسوأ بمراحل عند الحديث عن المسرح في سوريا، في البلد الخارج تواً من عقود تحطيمٍ للمجتمع، وغياب لحقوق التجمّع والتفكير بصوت مرتفع، ومركزيّة شديدة بالعلاقة مع المؤسّسات الثقافيّة والفنيّة، والكثير الكثير من الفساد والإفساد، والفقر في الإمكانيّات وربما أيضاً في المُخيّلة.
ولكن رغم ذلك كلّه، ورغم ضبابيّة اللحظة الحاليّة سياسيّاً، وبؤس الإمكانيّات والتشرذم الكبير للمسرحيّين والمسرحيّات السوريّين، تبدو اللحظة الحاليّة حُبلى بالكثير من الفرص التي يمكن للمسرح أن يستغلها ليلعب دوراً في سوريا في المستقبل، أو حتّى في الحاضر، وعلى الفور.
أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في سوريا اليوم هو سؤال العدالة، العدالة الانتقاليّة، غير الانتقاليّة، سَمِّها ما شئت، لكنّ السوريّات والسوريّين اليوم بحاجة، بعد رغيف الخبز وضوء المصباح وجرّة الغاز، إلى شكل من أشكال المحاسبة، للصفح والمسامحة وطَيّ صفحة الماضي ربما، لكنّهم بحاجة للنظر إلى تلك الصفحة مليّاً، والتأمّل فيها وتعلّم دروسها، وخلق معنى ما من مأساتها. الطريق المضمون نحو خراب قادم هو إخفاء صفحة الماضي تحت السجّادة، والاستمرار بالحياة وكأنّ شيئاً لم يكن.
دوناً عن الفنون الأخرى، يحمل المسرح في سوريا اليوم إمكانيّة كبيرة للَمس أسئلة العدالة المُلحّة، للتفكير فيها بصوت عالٍ، للحديث عنها مع السوريّين في سوريا، في كلّ مدنها وقُراها، وربّما في مدن وقرى العالم أجمع. أقول المسرح دوناً عن الفنون الأخرى، بسبب طبيعة الفنّ المسرحي على المستويين التقني والفكري.
فعلى المستوى التقني، يتميّز المسرح مقارنة مع فنون دراميّة أخرى، مثل السينما والتلفزيون، بالخِفّة والعمليّة في حال وجود الإرادة لصنعه. بإمكانك طبعاً أن تُنتِج مسرحيّة بمئات الآلاف من الدولارات، وبإمكانك أيضاً أن تُنتج مسرحيّة دون أيّ مقوّمات، يكفي أن يكون لديك مؤدٍّ ومُشاهد واحد ليكون لديك مسرحيّة، والتجربة السوريّة في السنوات السابقة مليئة بالأمثلة على محاولات صنع مسرح من اللاشيء تقريباً، سواء في المدن والأحياء المحاصرة، أو في مخيّمات اللجوء، أو حتّى في المعتقلات والسجون.
التراث المسرحي العالمي مليء أيضاً بالنماذج والتنظير لأشكال مسرحيّة «فقيرة» من حيث الأدوات وكبيرة من حيث التأثير، مثل المسرح الفقير ومسرح المضطهدين، وغيرها الكثير.
عقب سقوط النظام، كان المسرح أوّل وسيط فنّي ينتقل من الشتات السوري إلى داخل سوريا، وذلك ليس عبر وسائط تقنيّة كالفيديو أو الصوت أو الصورة، على أهميّتها، وإنّما عبر الجسد الحيّ لمؤديّه. على الأقل لدينا مثالان: الأوّل مسرحية المُهاجران للأخوين ملص على خشبة مسرح الخيّام في دمشق، إحدى خشبات المسرح «القومي»، والثاني مسرحيّة رح نبنيها على مسرح نقابة الفنّانين في حلب، من أداء يمان نجّار وسمير أكتع ومحمد جعفر وقمر الزمان برو.
وبغض النظر عن «السويّة الفنيّة» للعرضَين اللّذين لم يشاهدهُما كاتبُ هذه السطور، وعن الجدل الذي أحدثاه في أوساط المتابعين والمهتمين بالمشهد المسرحي، فإن المثال هنا عن الطبيعة الخاصّة للمسرح بالمقارنة مع فنون أخرى أكثر بُطأً من حيث سيرورتها، وتحتاج وقتاً وإمكانيّات أكبر بكثير للإنتاج.
أمّا على المستوى الفكري، وهو الأهم هنا، فالمسرح في سوريا يحمل اليوم إمكانيّة كبيرة للحديث عن كلّ ما جرى ويجري، حيث تُشكّل طبيعة الفنّ المسرحي القائمة على عرض الصراعات والتناقضات البشريّة على الخشبة، مساحة ضروريّة لعرض صراعاتنا السوريّة، وما أكثرها!
في أثينا القديمة لعب المسرح دوراً «تطهيريّاً» للجمهور الأثيني وفق التعبير الأرسطي. كان الجمهور يعيش خلال المسرحيّات الصراع بين الآلهة والبشر، الأبطال التراجيديّين، والذي ينتهي دائماً بفوز مشيئة الآلهة، وبنهاية فجائعيّة للبشر الممثَلّين على الخشبة. بعد كل عرض كان يخرج الجمهور، وفق أرسطو، بحالة من التطهير Catharsis أو التنفيس، بعد أن عاش لساعات مع الممثلين على الخشبة مشاعرَ مُركَّبة مثل الخوف والشفقة، فيخرج من المسرح مُتخفِّفاً من هذه المشاعر.
بعد أكثر من ألفي عام، قام الكاتب والمخرج الألماني برتولد بريشت بثورة على مفهوم التطهير الأرسطي، لينجز نظريّته عن المسرح الملحمي الذي كان ثورة على مفهوم التطهير الأرسطي، حيث رأى أن دور المسرح يكمن أيضاً في مخاطبة عقل المتفرّج، لا مشاعره فقط، وذلك بهدف فتح عينيه على الظروف السياسيّة والاقتصاديّة التي يعيش فيها، وربّما زرعِ نواة الثورة في داخله.
وسواء كان الصراع في المسرح بين الإنسان والآلهة، أو بين البشر وظروفهم الطبقيّة والسياسيّة، فإنّ الصراع مكوّن أساسي في الفنّ المسرحي، فالمسرح، وعبر تاريخه، كان قادراً دوماً على عكس الصراعات والتناقضات وإظهارها على الخشبة، دون الحاجة إلى تقديم اقتراحات لحلّ هذه الصراعات بالضرورة، فإن كانت السياسة بإحدى تعريفاتها هي «فن الممكن» فإنّ المسرح السوري اليوم قد يكون فنّ «غير الممكن»، أي مكان عرض الصراعات والتناقضات غير القابلة للحل، ولكن القابلة للتأمّل والتفكير، والشعور أيضاً.
مظلوميّة ومركزيّة
لا يخفى على أحد حجم الفوضى التي يتم التعامل بها اليوم مع أكثر الملفّات السوريّة أهميّة وحساسيّة: الاعتقال والإخفاء القسري، السلم الأهلي والعدالة الانتقاليّة، الاعتراف بالجرائم والمأساة، محاسبة المجرمين، وعشرات القضايا المُلحّة الأخرى. ومن تلك القضايا قضيّة الإحساس بالظلم عند قطّاعات واسعة خسرت كلّ ما تملكه في سنوات الثورة، حيث عانى كلّ السوريّين من الظلم والقهر والخوف تحت حكم الأسدين؛ لكن هل كانت الأثمان التي دفعتها المجتمعات السوريّة واحدة؟
المظلوميّة التاريخيّة بسبب أحداث قريبة أو بعيدة في التاريخ كانت دائماً وقوداً لأبشع الانتهاكات والجرائم في سوريا، ليست تجربة السوريّين واحدة في سنين الثورة أو حتى قبلها، والتعامي عن الفروقات بين ما جرى للمجتمعات السوريّة المختلفة لا يَعِدُ بكثير من العدل والفهم والسلم الأهلي في المستقبل، خاصّة إذا استمرّ التعامل مع هذه الملفّات بالخفّة والفوضى التي نعيشها اليوم.
للفنون السوريّة، وخاصّة الدراما التلفزيونيّة، تاريخ سيّء في تصوير المجتمعات السوريّة خارج المدينة، أو ربّما خارج دمشق تحديداً مع استثناءات قليلة، ولا يصعب على المراقب رؤية كميّة التسطيح والاختزال للمجتمعات الريفيّة السوريّة في الدراما التلفزيونيّة، الأمر الذي قيلَ فيه كلامٌ كثير.
السؤال اليوم، هل هذا التصوير المُجحِف والمُختزَل، نتيجة لعقليّة سيّاسيّة وثقافيّة مُعيّنة، سيتغيّر اليوم جذريّاً مع انطواء صفحة الأسد؟ أمّ أنّ العلاقة الملتبسة بين المركز و«الأطراف» في الفنّ السوري هي نتيجة بنيّة معقّدة لا يكفي الوعي بوجودها لتغييرها اليوم إلى غير رجعة.
بالعودة إلى «الخِفّة» التي يتمتّع بها المسرح، الفرصة متاحة اليوم ليلعب المسرح، دوناً ربّما عن فنون أخرى، دوراً في رفع العبء الثقيل لتاريخ المركزيّة الفنيّة والثقافيّة في سوريا، ولفتح حوار في مجتمعات ومدن وبلدات وقرى أُشعِرَ سُكّانها على مدى عقود أنّ حياتهم وآراءهم ليست جديرة بالنقل إلى خشبات المسارح وشاشات التلفاز، وأنّ حياتهم نفسها ليست مُهمّة في حال اعترضوا على الطريقة التي يُحكَمون بها. الحوار المُركَّب الذي يخلقه المسرح وفق تعبير ونّوس، هو ضرورة اليوم لبناء مجتمع سوري جديد على أنقاض المجتمع المشوّه الذي ورثناه من سوريا الأبد.
هل يبدو الكلام السابق مُفرِطاً في التفاؤل بدور المسرح في ظلّ الواقع السوري الحالي؟ وفي ظلّ مخاوف مشروعة من إمكانيّة إغلاق باب الفنون كلّه إلى غير رجعة من قبل الحاكمين الحاليّين؟ ربّما، لكن كما في عبارة ونوّس الشهيرة التي كانت يوماً على حيطان مدينة سراقب، فإنّنا ما زلنا محكومين بالأمل، وربّما لا نملك تقريباً أيّ شيء سواه في سوريا اليوم.
موقع الحمهورية
———————————-
هل بدأ الانفتاح المصري على القيادة السورية الجديدة؟/ عبدالله تركماني
2025.02.18
بعد أن قرّرت جامعة الدول العربية دعوة الرئيس أحمد الشرع إلى القمة العربية الطارئة في القاهرة، بتاريخ 27 شباط/ فبراير، لبحث المخاطر التي تحيط بالشعب الفلسطيني في غزة، واحتمال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة، يبدو أنّ الانفتاح المصري على سوريا الجديدة بات ممكناً، انطلاقاً من أنه لا توجد عداوات أو صداقات دائمة وإنما مصالح تتكفل بالانتقال من هذه الضفة إلى الأخرى.
ولعلَّ هذا الانتقال بات مؤكداً بعد أن أرسلت القيادة السورية للمرحلة الانتقالية إشارات إيجابية عديدة للقيادة المصرية، ومن مؤشرات ذلك تهنئة الرئيس المصري للرئيس الشرع بعد تنصيبه رئيساً، مما يشير إلى بداية التعامل مع قيادة سوريا الجديدة، وبالتالي بداية الخروج من حالة الجمود في العلاقات.
ولا شكَّ أنّ زيارات العديد من مسؤولي القوى العربية والدولية، إضافة إلى سعي الإدارة السورية للانخراط في المحيط العربي وحرصها على استقرار وأمن المنطقة، وأنها ليست بوارد تصدير الثورة، بل الاهتمام بإعادة إعمار سوريا، دفعت القيادة المصرية في اتجاه هذا الانفتاح، كي توازن بين مصالحها الإقليمية، بعد أن استنكفت عن الاعتراف بالقيادة السورية الجديدة، على طريق تجاوز العوائق التي تعيق التطبيع المصري-السوري الكامل، خاصة ما يتعلق بقيادات مصرية في المؤسسة العسكرية السورية الجديدة، متهمة بأنشطة تنطوي على تهديدات أمنية، إشارة إلى (علاء محمد عبد الباقي) الذي كان قد حُكم في مصر غيابياً بتهمة الإرهاب، عام 2016.
وفي الواقع كان وزير الخارجية المصري قد اتصل بنظيره السوري، بصفة ديبلوماسية وليست سياسية، أواخر السنة الفائتة، لاستكشاف توجهات الإدارة الجديدة، وفي الوقت نفسه إملاء شروط تكرر المطالب المحقة للمجتمع الدولي، أي “ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً، وتعكس التعددية والتنوع في المجتمع السوري”، إضافة إلى عدم توفير ملاذ آمن للعناصر المصرية المتطرفة، بل المطالبة بتسليم مَن صدرت بحقهم أحكام قضائية، واكتفت الإدارة السورية بـ”عدم السماح لهؤلاء بأي نشاط يهدد الأمن المصري مستقبلاً”.
وكان الوزير المصري قد شارك باجتماع مدينة العقبة الأردنية، في 14 كانون الأول/ ديسمبر، لبحث مستجدات التغيير في سوريا، حيث أكد على أهمية “تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية تضم كل مكوّنات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية”.
ولكنّ الإدارة المصرية أعلنت إجراءات تتضمن ضرورة حصول السوريين، القادمين من مختلف الدول على موافقة أمن الدولة المصري، مما يعكس عقدة المخاوف الأمنية من كل ما يتعلق بـ”الإسلام السياسي”.
ويبدو أنّ القلق من تركيا، التي احتضنت إخوان مصر، قد انسحب على القيادة السورية الجديدة، ومما زاد من هذا القلق ظهور بعض قيادات إخوان مصر في دمشق إلى جانب مسؤولين أتراك وسوريين.
وفي الواقع تدرك القيادة المصرية أنّ استمرار قلقها من المستجدات السورية يمنح قوى إقليمية أخرى مزايا على حساب مصالحها، وفي المقابل تعي قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا أهمية انفتاحها على محيطها الإقليمي، بعيداً عن التطرف والعنف، بل بأن تكون عامل أمن واستقرار في المنطقة.
وكان وزير الخارجية السوري قد التقى نظيره المصري، برعاية وزير خارجية تركيا، وفق صحيفة “العربي الجديد”، إذ أوضحت الصحيفة أن الشيباني وعبد العاطي اتفقا خلال اللقاء على “مراعاة الملاحظات والمخاوف المصرية إزاء الوضع في سوريا، وضمان عدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار، أو استخدام أراضيها كقاعدة لأي نوع من الهجمات ضد مصر”، تأكيداً لما كانت القيادة السورية قد أكدته سابقاً برغبتها في بناء علاقات تقوم على احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما.
وكانت الإدارة السورية قد تجاوبت مع بعض المخاوف المصرية، حيث طردت (عبد الرحمن يوسف القرضاوي) من دمشق، وحجّمت من تحركات عناصر إخوانية سببت إزعاجاً لمصر.
وقد تكون إعادة إعمار سوريا مدخلاً اقتصادياً مصلحياً مناسباً للقيادة المصرية، من خلال مساهمة الخبرات المصرية في تشييد البنى التحتية، إضافة إلى الثقل المالي لتجار سوريين في مصر يمكن أن يشكلوا قاطرة لتنشيط العلاقات، كي تعيد النظر ببرودها السياسي المبالغ فيه إزاء القيادة السورية الجديدة، فيما تبقى التهديدات من قوى إقليمية غائبة عن الحسابات الاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالعلاقات العربية-الإسرائيلية، أو بأمن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
تلفزيون سوريا
————————–
أشياء لا يريد السوريون مشاهدتها في سوريا الجديدة.. ما هي؟/ عبد الناصر القادري
2025.02.17
في غضون أيام من انطلاق معركة ردع العدوان، سقط النظام وهرب بشار الأسد، بعد سنوات طوال من تضحيات الشعب السوري وبذل الغالي والنفيس لأجل الحرية.
عاش الشعب السوري أكثر من خمسة عقود تحت حكم نظام بوليسي استبدادي منع الشعب من التنفس وسرق معظم موارد البلاد وكمّم الأفواه، حيث طغت المحسوبيات والفساد والرشوة، إلى أن فجّر السوريون ثورتهم وخرجوا بمظاهرات سلمية ضد النظام، الذي ردّ عليهم بالاعتقال والرصاص الحي وصولاً إلى القصف وتدمير المدن على رؤوسهم والتهجير والتغيير الديموغرافي الممنهج والقتل تحت التعذيب في حرب معلنة ضد الشعب، لا ينسى السوريون أيامها الكارثية عليهم وعلى عائلاتهم.
وفي جولات لـ موقع تلفزيون سوريا في دمشق وريفها، والتي سألنا خلالها السوريون عن الأشياء التي لا يريدون رؤيتها في سوريا بعد اليوم، كانت إجاباتهم متنوعة وتحمل كثيرا من الغصة والتفاؤل في الوقت نفسه.
يقيس التقرير آراء عدد من السوريين بخصوص التغيّرات المتوقعة بعد إسقاط النظام وكيف يمكن أن تتحسن أو تتغير الممارسات التي كانت سائدة في فترة حكمه وما الذي سيختفي كلياً في سوريا الجديدة.
تباينت الآراء والأفكار بين من سألناهم، ولكن تركّزت الإجابات عن أهمية اختفاء الخوف إلى الأبد، وانتهاء مرحلة الجيش الإلزامي (ولو بشكل مؤقت)، وعدم وجود اعتقالات وسجون لأسباب كيدية وسياسية وتعسفية، وكسر جميع أصنام وتماثيل حافظ وبشار الأسد، نزع صور الحكم المخلوع وأعلامه ورموزه وإشاراته ومقولاته، توقف الحرب بالمعنى التقليدي التي كانت تزج بالسوريين في معارك غير منتهية، اختفاء الوساطات والرشى وغير ذلك.
وحاول التقرير أن يستوفي التنوّع الموجود في العاصمة دمشق وريفها، حيث التقينا بأشخاص من جميع المحافظات السوريّة وبمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.
ومع أن الناس يعيشون في أوضاع صعبة، إلا أنهم يعيشون سعادة النصر حتى بعد مرور أكثر من شهرين على هزيمة النظام وانقلاب حياة مختلف فئات الشعب إلى شكل لم يتخيلوه قبل يوم 27 تشرين الثاني 2024.
ويتجسّد ما ركز عليه السوريون الذين قابلهم موقع تلفزيون سوريا، بين الأشياء التي لا يريدون أن يروها في سوريا الجديدة بأي شكل من الأشكال:
“لا نريد معتقلات”
يؤكد مَن استطلعنا آراءهم أنهم لا يريدون أن يكون في سوريا الجديدة معتقلات للرأي ولا فروعا أمنية تحصي أنفاس السوريين وتكمّم أفواههم، خصوصاً بعد صور قيصر لعشرات آلاف السوريين الذين قتلوا تحت التعذيب وخارج نطاق القانون بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وزجهم في سجون تحت الأرض غير آدمية ولا تليق بالبشر.
وشدّدوا على أن هذه المعتقلات، كانت مسارح جرائم ارتكبت بها قوات نظام الأسد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ومورس فيها كل أنواع التعذيب والاغتصاب والقتل الجماعي مع حرمان كامل لكل الحقوق المدنية، مع إشارتهم تحديداً إلى سجن تدمر وسجن صيدنايا وفرع فلسطين وفرع المنطقة.
“لا نريد أن نخاف من الدولة”
سبق أن زرع نظام المخلوع، الرعب والخوف في قلوب السوريين، فأصحبوا يخشون من الدولة ويخافون منها أكثر من أي عدو يتربّص بهم.
وكان حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد، قد حوّلا الدولة إلى “وحش” يلاحق أنفاس السوريين عبر سلسلة غير منتهية من كتبة التقارير الذين تحصي حركات السوريين وسكناتهم وصلواتهم وأعمالهم وأرزاقهم وسفراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم، مشيرين إلى السجلات الأمنية التي وُجدت في فروع المخابرات بعد وصول المقاتلين إلى دمشق.
“لا نريد جيشاً يقتلنا”
يقول أحد الذين استطلعنا آراءهم، إنه يمر على الحواجز ويشعر بالسعادة الآن، كان الجيش السابق جيشاً طائفياً فاسداً، أما الآن لدينا جيش محترم، نخاف عليه ونشفق على تعبه، لا يسرق منا قوت أولادنا على الحواجز، ولا ينهبون سيارتنا عند تفتيشها، ولا يطلبون رشوة أو مالاً ويعاملوننا بكل احترام.
وتابع: “جيش نخاف عليه لا نخاف منه، يحمينا ولا يقتلنا، جيش لا يقصفنا بالطائرات والسلاح الكيماوي، جيش لا يقتحم البيوت الآمنة من دون إذن قضائي أو سبب قاهر، جيش ندفع له من أموالنا لأننا لن تسرق”.
وأكّد آخرون أن إلزامية الجيش يقررها مَن سيعد الدستور الجديد للبلاد، المهم هو أن يكون جيش لحماية الشعب والدولة وليس لحماية الرئيس والحكومة، جيش احترافي يدافع عن البلد وشعبه وحدوده وثرواته ومقدراته، موجود في الثكنات وليس في الشوارع والطرقات.
“لا نريد تهديدا بالأهل والأقارب”
من الأشياء التي تطرق إليها المستطلعون، هو أنهم لا يريدون ملاحقة أحد بجريرة أحد، كما كان يفعل نظام المخلوع، فإن لم يجد الشخص المطلوب اعتقل أو لاحق الأب والأم والإخوة وأبناء العمومة والأخوال والجد والجدة في حالة نادرة الحدوث في العالم.
ولفت البعض إلى أن القانون لا يحاسب سوى مرتكب الجرم لكن في عهد النظام المخلوع كان الجار يحاسب أحياناً لأن جاره متهم سياسي، وهو ما حصل في الثمانينيات في حماة، وفي عموم المحافظات السورية إثر اندلاع الثورة إذ كان النظام يلاحق جميع أفراد العائلة من أجل معاقبة فرد واحد.
“لا نريد تماثيل وصور الرئيس في كل مكان”
مع خروج المتظاهرين في الثورة السورية بدؤوا بإزالة صور حافظ وبشار الأسد وكسروا تماثيله وزادوا في شتمه ولعنه لأنهم كانوا على يقين بأنه كان يأمر بقتلهم، وإن كان الرئيس مجرد موظف حكومي عندهم لم يتمكنوا من اختياره أو انتخابه.
ومع ذلك بعد استعادة النظام سيطرته على المدن المدمرة بدعم روسي إيراني لم يعمر أي شيء بل سرق حديد كل المباني والبيوت وأعاد بناء تماثيل حافظ وبشار الأسد.
ومع بدء عملية ردع العدوان كان المقاتلون بمشاركة الشعب يُسقطون تماثيل كل عائلة الأسد ويهدمونها للمرة الأخيرة حتى إنهم لم يبقوا ولا واحداً من عشرات التماثيل التي أخذت من مال الشعب.
كذلك، علّقوا أنهم لا يريدون رؤية صور الرئيس بكل مكان خارج الدوائر الحكومية، إن كان ذلك يتوافق مع الدستور الجديد والقوانين الناظمة في البلد، وأن يبقى اسم سوريا بلا كنية فهي لم تكن “سوريا الأسد” بل سوريا الحرة.
“لا نريد دفع رشاوي”
في عهد النظام المخلوع، عام 2024، كانت سوريا في مؤخرة مؤشر الفساد العالمي، حيث سجّلت 13 درجة من أصل 100، لتحتل مع الصومال المركزين الأخيرين، وفقاً لتقرير “منظمة الشفافية الدولية”.
وتُظهر البيانات أن الأنظمة الاستبدادية تؤدي إلى تعزيز الفساد والإفلات من العقاب، وكان الفساد ينخر في جميع مؤسسات الدولة ووزارتها ومديرياتها ومحافظاتها وبلدياتها وصولاً إلى المخاتير وعمال النظافة.
بعد أكثر من شهرين على سقوط النظام، بدأ الناس يشعرون بالفرق حيث لم يعد أحد يدفع رشوة على حاجز عسكري أو لشرطي مرور أو في دائرة حكومية.
وانطلاقاً من ذلك، أكّد مَن استطلعنا آراءهم أنهم لا يريدون أن يكون هناك دفع رشاوى ضمن أي مؤسسة في سوريا الجديدة، وأن تكون جميع المعاملات والأوراق خاضعة للقانون والرسوم النظامية المعلن عنها.
“لا نريد محسوبيات”
تعد مسألة التوظيف في سوريا من الأمور الشائكة التي كانت مثار شكوى بين السوريين، حيث يوظف أبناء المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم في مؤسسات الدولة ويعينون بناء على أسمائهم وكناهم وطوائفهم أيضاً من دون النظر إلى كفاءتهم ونظافة أيديهم، فتحرم البلد من الكفاءات والمتعلمين فيهاجرون من سوريا أو يعملون بالأعمال الحرة بعيداً عن تخصصاتهم.
في سوريا الجديدة يطالب سوريون أن تكون الوظائف والتعيينات بناء على الكفاءة والخبرة من دون وجود محسوبيات ووساطات، وذلك وفق أنظمة ولوائح وقوانين تساوي بين جميع المواطنين السوريين.
———————————
التصعيد الإسرائيلي في سورية مطلع عام 2025:الغارات، الأهداف، والتداعيات
نشر في 18 شباط/فبراير ,2025
منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، ازداد التصعيد الإسرائيلي في سورية، واتخذ منحًى جديدًا مطلع عام 2025، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية بشكل ملحوظ، واستهدفت مواقع استراتيجية عسكرية كانت تنشط فيها مجموعات مرتبطة بإيران وحزب الله، وجاء هذا التصعيد في ظل الفراغ الأمني الناتج عن سقوط نظام بشار الأسد، حيث استغلته إسرائيل لتحقيق أهدافها وإعادة تشكيل موازين القوى في الجنوب السوري.
وتمحورت الاستراتيجية الإسرائيلية حول تحقيق مجموعة من الأهداف الأمنية والعسكرية، أبرزها تعزيز أمنها القومي، ومنع إعادة تموضع الخلايا المرتبطة بإيران أو حزب الله، إضافة إلى توسيع نطاق نفوذها العسكري في العمق السوري. لذلك اعتمدت نهجًا عسكريًا متعدد الأوجه، شمل ضربات جوية دقيقة، وعمليات استهداف نوعية، إلى جانب تعزيز وجودها الأمني والعسكري عبر إنشاء بنى تحتية جديدة في المنطقة العازلة.
تسلّط هذه الورقة الضوء على تفاصيل العمليات الإسرائيلية (الغارات الجوية والتوغل البري)، منذ مطلع عام 2025، مع تحليل أبعاد التوسع البري الإسرائيلي، والأهداف الاستراتيجية الكامنة وراء هذه التحركات، والتداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي والدولي، والتوازنات العسكرية في جنوب سورية، وردود الفعل المحتملة من الأطراف الفاعلة في المشهد السوري.
التصعيد الجوي
كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية مطلع عام 2025، مستهدفة مواقع عسكرية استراتيجية وشخصيات مرتبطة بجماعات مسلحة مختلفة، وتأتي هذه الإجراءات -بحسب زعم شخصيات حكومية ومن الإعلام الإسرائيلي الرسمي- في إطار جهود إسرائيل المستمرة لمواجهة التهديدات من الميليشيات المدعومة من إيران، وحزب الله داخل الأراضي السورية[1].
جدول رقم (1): الغارات الإسرائيلية في سورية: المواقع المستهدفة والتفاصيل (كانون الثاني/ يناير – 10 شباط/ فبراير 2025)
شهدت الضربات الإسرائيلية تباينًا في توزيعها بين المحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظة حلب 7 ضربات من أصل 11، كانت سبع ضربات على خمس مستودعات في منطقة معامل الدفاع، إضافة إلى ضربة استهدفت بناءً كاملًا، وأخرى استهدفت موقع رادار في نفس المنطقة بالسفيرة.
وفي ريف دمشق، نُفّذت ضربتان، استهدفت الأولى قاعدة عسكرية قرب سعسع كانت تستخدمها إيران خلال حكم الأسد، واستهدفت الثانية مستودعًا في منطقة دير علي، قرب الكسوة، زعمت التقارير الإسرائيلية أنه يحتوي على أسلحة لحماس. أما في السويداء فقد وقعت ضربة واحدة فقط، استهدفت مستودعًا داخل قاعدة خلخلة الجوية. وكانت هناك ضربة واحدة فقط في ريف القنيطرة الجنوبي، ونتج عنها مقتل شخص. [2]
التصعيد البري
استغلّت إسرائيل الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد في جنوب سورية، لتعزيز وجودها العسكري، متجاوزةً “خط ألفا” المحدد في اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، فخلال الأسبوع الأول من العمليات الإسرائيلية في المنطقة، فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على مساحة 303 كيلومترات مربعة، ومع استمرار العمليات خلال كانون الثاني/ يناير 2025، انسحبت الوحدات الإسرائيلية من منطقة حوض اليرموك، لكنها وسّعت نطاق انتشارها على المحاور الشمالية، مما أدى إلى زيادة المساحة الخاضعة لسيطرتها إلى 366 كيلومترًا مربعًا مع نهاية الشهر.
لاحقًا، عززت إسرائيل انتشارها في المنطقة المنزوعة السلاح، حيث فرضت السيطرة إما عبر الانتشار المباشر أو من خلال السيطرة النارية التي استخدمتها لتقييد حركة المدنيين، ومنع قوات أمن الحكومة السورية من تنفيذ أي عمليات داخل المنطقة. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم المساحة التي تقع تحت السيطرة المباشرة أو التأثير الإسرائيلي إلى أكثر من 460 كيلومترًا مربعًا.
وبالتزامن مع التقدّم البري وتمشيط المنطقة بحثًا عن أسلحة خلفتها التشكيلات التي كانت تعمل مع إيران وحزب الله، أنشأت القوات الإسرائيلية نقاطًا عسكرية جديدة داخل المنطقة العازلة، التي كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، مبررةً ذلك بضرورة حماية أمنها القومي، ومنع استغلال الخلايا الموالية لإيران وحزب الله للفراغ الناجم عن انهيار النظام السوري، وكانت تلك الخلايا تنشط في مناطق مختلفة في المنطقة في فترة نظام الأسد، حيث نفّذت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق في جنوب سورية، بهدف تدمير القدرات العسكرية السورية، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، وتقدّمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في القنيطرة، مستهدفة مواقع استراتيجية، أبرزها قمة عرنة في جبل الشيخ، حيث أنشأت نقاط مراقبة وثكنات عسكرية بعد أيام من توغلها[3].
في التلول الحمر، شرق بلدة حضر، استغلّت القوات الإسرائيلية انسحاب القوات الروسية لتعزيز وجودها بإنشاء قاعدة عسكرية توفّر سيطرة واضحة على المنطقة. وعلى سفوح جبل الشيخ، تحديدًا في قرص النفل شمال غرب حضر، عملت على فتح طرق جديدة وتعبيدها، ومدّ خطوط كهرباء لإنارة الموقع، ما عزّز من مراقبتها للشريط الحدودي وريف القنيطرة الشمالي.
وفي جباتا الخشب، بالقرب من برج الزراعة داخل المحمية الطبيعية، تم تجهيز نقطة عسكرية متكاملة تضم مهبطًا للطائرات المروحية وغرفًا مسبقة الصنع لإيواء العناصر، مع تأمين طريق يربطها بالحدود. وتمركزت وحدات عسكرية شمال بلدة الحميدية، بعد تجهيز الموقع بالكامل وإنارته، ليشكل نقطة متقدمة بديلة عن المباني الحكومية التي أُخلِيت. وفي العدنانية، قرب سد المنطرة، اختارت القوات الإسرائيلية تلة مرتفعة لإنشاء نقطة جديدة يجري تجهيزها حاليًا، في حين شهدت مدينة القنيطرة، قرب برج القنيطرة، تجهيز موقع مماثل لتعزيز السيطرة الميدانية.
وفي القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة، تم تفعيل الموقع العسكري في تل أحمر الغربي قرب بلدة كودنا بعد استكمال تجهيزه، حيث يتمتع بإحداثيات تكتيكية تمنحه إشرافًا ميدانيًا واسعًا، يمتد نحو ريف القنيطرة الجنوبي وأجزاء كبيرة من ريف درعا الغربي، ما يعزز القدرة الاستخباراتية، ويرفع من كفاءة المراقبة والسيطرة العملياتية في المنطقة.
الأهداف الإسرائيلية والتداعيات المحتملة
تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي وإمكانية التصعيد العسكري
تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، بهدف الحد من التهديدات الأمنية المحتملة، لا سيما من قبل خلايا إيران وحزب الله أو الجماعات المسلحة غير النظامية، وعلى الرغم من أن النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة قد تراجع، فإن إسرائيل تعتبر أن شبكات الدعم اللوجستي والبنية الاستخباراتية لهذه القوى لا تزال موجودة، وتعدّها مصدر تهديد مستقبلي.
لكن من الممكن أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة التوترات الأمنية في الجنوب السوري، حيث قد ترى الحكومة السورية الجديدة أن التوسع العسكري الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وقد يدفعها ذلك إلى تعزيز انتشارها العسكري أو اتخاذ إجراءات ميدانية لمراقبة التحركات الإسرائيلية عن كثب، ومن المتوقع أن تثير إقامة القواعد العسكرية الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة اعتراضاتٍ من الأمم المتحدة، حيث قد يُنظر إليها على أنها مخالفة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، مما قد يدفع المنظمة الأممية إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لمراجعة هذه الإجراءات.
منع إعادة تموضع القوات الإيرانية وحزب الله وتأثيره في التوازن الإقليمي
تخشى إسرائيل من أن تستغل الميليشيات المدعومة من إيران الفراغ الأمني في الجنوب السوري وأن تسعى لإعادة انتشارها، ولذلك، فإن التحركات الإسرائيلية، ومنها إنشاء قواعد عسكرية دائمة، تأتي كإجراء احترازي لمنع أي إعادة تموضع لخلايا وتشكيلات تتبع لإيران أو لحزب الله اللبناني.
في المقابل، قد تدفع هذه التحركات الإسرائيلية إيران وحزب الله إلى تعديل تكتيكاتهما العسكرية. ومن المحتمل أن يلجأ الطرفان إلى تعزيز وجود خلايا أمنية نائمة أو سرية، وتكثيف أنشطتهما الاستخباراتية في المنطقة. هذا التغيير في الاستراتيجية قد يؤدي إلى تصاعد حرب استخباراتية غير معلنة بين الأطراف المعنية.
تغيير قواعد الاشتباك وإمكانية التأثير في الردع الإسرائيلي
من خلال تعزيز وجودها العسكري في الجنوب السوري، قد تسعى إسرائيل إلى تعديل قواعد الاشتباك بطريقةٍ تمنحها مرونة أكبر في تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف عسكرية داخل سورية، دون الحاجة إلى عمليات برية واسعة النطاق، ويُنظر إلى هذا النهج كجزء من استراتيجية الردع الإسرائيلي التي تهدف إلى تقليل المخاطر الأمنية على المدى الطويل.
قد يؤدي تعديل قواعد الاشتباك إلى زيادة احتمالية المواجهة، حيث من المتوقع أن تعمل القوات السورية الجديدة على تعزيز قدراتها الدفاعية، سواء عبر نشر أنظمة دفاع جوي أكثر تطورًا، أو من خلال رفع مستوى جاهزية وحداتها العسكرية في المناطق الحدودية. ومن الممكن أن تواجه إسرائيل ضغوطًا دبلوماسية من الولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تجنب أي تصعيد قد يؤثر في الاستقرار الإقليمي. وفي حال استمر التوسع الإسرائيلي في الجنوب السوري، فمن المتوقع أن تتصاعد المطالبات الدولية بضرورة ضبط هذه التحركات ضمن إطار تفاهمات دبلوماسية لتجنب تصعيد غير ضروري.
السيطرة على الممرات الاستراتيجية وإمكانية تعقيد مستقبل الجنوب السوري
بالإضافة إلى الأهداف الأمنية، قد تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى الجولان ودمشق، عبر إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة، وقد يمنحها هذا ميزة استراتيجية تتيح لها مراقبة التحركات العسكرية السورية، وإضعاف قدرة أي طرف آخر على إعادة تنظيم قواته في المنطقة، وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سورية بالعاصمة دمشق، مرورًا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان. ومن أبرز هذه الممرات:
طريق دمشق-القنيطرة: وهو أحد أهمّ الطرق التي تربط العاصمة السورية بمنطقة الجولان، ويمثل شريانًا استراتيجيًا يتيح للجيش السوري أو أي قوى أخرى إعادة الانتشار أو نقل التعزيزات العسكرية.
طريق خان أرنبة-جباتا الخشب-الجولان: وهو ممر مهم، يتحكم في حركة القوات في منطقة القنيطرة، ويمثل نقطة عبور حيوية نحو المناطق الحدودية.
الممرات الجبلية في سفوح جبل الشيخ: حيث توفر تضاريس المنطقة طرقًا عن الطرق الرئيسية من أجل ارسال تعزيزات والتحرك في المنطقة.
من الممكن أن يؤدي هذا التوجه إلى إعاقة أي جهود مستقبلية لاستعادة السيادة السورية الكاملة على الجنوب، حيث قد تصبح مسألة الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق نقطة خلاف جوهرية في أي مفاوضات سياسية مقبلة حول مستقبل سورية، وإن استمرار تعزيز القواعد الإسرائيلية قد يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، حيث قد تصبح قضية الانسحاب الإسرائيلي جزءًا من الترتيبات الأمنية التي تحتاج إلى توافق دولي وإقليمي لحلها.
موقف الحكومة السورية الجديدة من التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري:
في ظل التوغلات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة في التعامل مع هذه التحركات، وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة، ومنها تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي، فإن تأثير هذه المساعي يبقى محدودًا، بسبب عدم الاعتراف الدولي الكامل بالحكومة الجديدة، مما يضعف من قدرتها على حشد دعم دولي فعّال للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية[4].
من جهتها، تبرّر إسرائيل وجودها العسكري في الجنوب السوري بحماية أمنها القومي ومنع أي تهديدات محتملة من الأراضي السورية، وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في المواقع الاستراتيجية، مثل جبل الشيخ، لأجل غير مسمّى، مما يعكس نيّة إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة[5].
وهذا التوسع الإسرائيلي المتكرر يُثير قلقًا متزايدًا بين السكان المحليين في الجنوب السوري، حيث أفادت تقارير بحدوث احتجاجات وتظاهرات ضد الوجود الإسرائيلي، إضافة إلى مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمواطنين السوريين. هذه التوترات المتصاعدة تزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، وتضع الحكومة السورية الجديدة أمام تحديات إضافية في سعيها لاستعادة السيادة الكاملة على أراضيها وضمان أمن وسلامة مواطنيها [6].
السيناريوهات المحتملة
في ظلّ استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سورية، بعد سقوط نظام الأسد، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل المنطقة بناءً على التفاعل بين القوى الإقليمية والدولية، وطبيعة الردود المحتملة من الأطراف المعنية:
السيناريو الأول: استمرار التصعيد العسكري
قد تواصل إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل سورية، مستغلةً الفراغ الأمني والاضطرابات الداخلية، وهذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع الجيش السوري الجديد، الذي يسعى إلى إعادة فرض سيطرته على الجنوب، إضافة إلى احتمالية تصاعد الضغوط الإقليمية، لا سيّما من الأردن، الذي يراقب بقلق التطورات على حدوده الشمالية، وقد يدفع استمرار التصعيد الحكومة السورية إلى إعادة تموضعها، أو السعي للحصول على دعم خارجي من أحد الحلفاء، ومنهم تركيا على سبيل المثال، لموازنة النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
السيناريو الثاني: تدخلات دولية وإقليمية (وهو السيناريو المرجَّح)
من الممكن أن تؤدي العمليات الإسرائيلية المكثفة إلى ردود فعل دولية متزايدة، حيث قد تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التدخل لاحتواء التوتر، وقد يأتي هذا التدخل عبر ضغوط دبلوماسية على إسرائيل للحدّ من توسعها العسكري أو من خلال محاولات لإعادة التوازن الأمني في المنطقة، عبر ترتيبات جديدة تشمل مشاركة أطراف دولية في مراقبة الحدود أو تعزيز وجود قوات حفظ السلام.
السيناريو الثالث: تسوية سياسية وإعادة ترسيم مناطق النفوذ
في ظل الضغوط الإقليمية والدولية، قد تتحرك الحكومة السورية الجديدة نحو إبرام تسوية سياسية، تشمل إعادة ترسيم مناطق النفوذ والانتشار في الجنوب مع الجانب الإسرائيلي، مع وضع آليات تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. إلا أن نجاح هذا السيناريو سيعتمد على قدرة الأطراف الفاعلة على إيجاد حلول وسط، تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية الإسرائيلية، والتوازنات الإقليمية، وإمكانية فرض الترتيبات الأمنية الجديدة على الأرض.
خاتمة
تشير التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سورية مطلع 2025 إلى تحوّل استراتيجي بعيد المدى، حيث عملت إسرائيل على استغلال الفراغ الأمني والسياسي الناجم عن سقوط النظام السوري لتعزيز سيطرتها الميدانية، سواء عبر الضربات الجوية المكثفة أو التوسع البري في المنطقة العازلة. وعلى الرغم من التبريرات الإسرائيلية بأن هذه التحركات تهدف إلى حماية أمنها القومي، ومنع إعادة تموضع الميليشيات المدعومة من إيران، فإن التداعيات المحتملة قد تتجاوز الأهداف التكتيكية قصيرة المدى لتشمل تصعيدًا عسكريًا أوسع، وزيادة التوترات مع القوى الإقليمية، وإعادة تشكيل معادلات النفوذ في الجنوب السوري.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل المشهد العسكري في سورية مرهونًا بتفاعل الأطراف الفاعلة، سواء من خلال استمرار التوسع الإسرائيلي والردود السورية المحتملة، أو عبر تدخلات إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء التصعيد. وستتأثّر السيناريوهات القادمة بمدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على استعادة السيطرة على المناطق الحدودية، وبموقف إسرائيل هل ستسعى لترسيخ واقع أمني جديد في الجنوب السوري أم ستُجري تحركات مضادة تعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
[1] لماذا هاجمت إسرائيل سوريا في هذا التوقيت؟، الجزيرة، نشر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2024، شوهد في 9 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://shorturl.at/E34i2
[2] معلومات الضربات الإسرائيلية هي من أرشيف الرصد الخاص في مركز حرمون.
[3] مقابلة أجراها الباحث مع مصدر خاص في القنيطرة، بتاريخ 12/13 شباط/ فبراير 2025
[4] ما تبعات إعلان إسرائيل وجودها الدائم في سوريا؟، الحرة، 12 شباط/ فبراير 2025، شوهد في 16 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://shorturl.at/Ph11B
[5] وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى على جبل الشيخ بسوريا لأجل غير مسمى، CNBC عربية، 29 كانون الثاني/ يناير 2025، شوهد في 15 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://shorturl.at/ke7Da
[6] إسرائيل تتغول في الجنوب السوري: تعزيز الاحتلال يقابل بمقاومة محلية، العربي الجديد، 3 كانون الثاني/ يناير 2025، شوهد في 16 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://shorturl.at/Lseqz
مركز حرمون
——————————
قافلة الحل السورية وملف شرق الفرات/ براء صبري
17-02-2025
لا ينفك يراقب المتابعون مصير المفاوضات القائمة بين قيادة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحكومة العدالة والتنمية وزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبدالله أوجلان لمعرفة مسار القضايا العديدة المرتبطة بهذا الملف الذي يتجاوز تأثيراته الجغرافية التركية، ويصل إلى عموم سوريا والعراق وإيران. المفاوضات التي لا بد ان يكون لها دور بارز في تحديد آليات حل الإشكاليات بين أنقرة وجبال قنديل، سيكون لها أيضاً دور بارز في تسهيل مهمة حل الإشكاليات الحالية بين القامشلي ودمشق. قسد، التي تتهمها تركيا مرارا بتبعيتها للعمال الكردستاني، تدرك أن وصول الطرفين، وأقصد هنا العمال الكردستاني والدولة التركية، إلى حل ديمقراطي يؤمن السلام للشعبين الكردي والتركي وعموم تركيا سيبعد المخاطر المرتبطة بهجمات تركية جديدة على شمال وشرق سوريا، ويُخفف من التهم تلك عنها. خاصة، إن قسد نفسها تبحث عن حل سلمي وديمقراطي للخلافات غير المحلولة لهذه اللحظة مع حكومة دمشق رغم مرور ما يقارب الشهرين من سقوط نظام الأسد. وهذا يزيد من اعباء ومخاوف السكان المحليين في شرق الفرات من ضبابية المسار السياسي والأمني لمصير ما يزيد عن ثلث سكان وجغرافية سوريا المتمركزة في شمال وشرق سوريا.
الحوارات الحالية بين تركيا وإيمرالي التي وصلت قافلتها التي يقودها قادة حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” إلى أربيل، وتسير نحو السليمانية، وتستمر في تواصلها مع إيمرالي وأنقرة وقادة قنديل، يبدو في طريقها للنضوج والظهور للعلن. هذه الحوارات مرتبطة أيضاً بالعوامل الداخلية الانتخابية والحزبية في تركيا أكثر ما هي مرتبطة بالتفاصيل الأمنية الحالية لخطوط الاشتباك المرتبطة بتركيا، والممتدة من سد تشرين إلى المثلث الحدودي القابع بين تركيا وإيران وإقليم كُردستان العراق. الربط بين سد تشرين والمثلث الحدودي هو ربط افتراضي تركي تنفذه أطراف تابعة لها على كونها حقائق ووقائع لا جدال فيها. وهذا يدفع المنطقة التي تحكمها الإدارة الذاتية للانهاك والنزف المستمر. ربط تحاول قسد مراراً الابتعاد عنه دون قبول تركي عمدي هدفه فيما يبدو الضغط عبرها على الأطراف الكردية في تركيا، واستخدامها لكسب النقاط في ملفاتها الداخلية. الضغط الذي يستغل ترابط الدم بين الأطراف الكردية بصورة فيها الكثير من الانتهازية السياسية. هذا رغم اصرار قسد على كونها ذات هوية محلية سورية بعيدة كل البعد عن الأطر القومية التي تحاول تركيا تطبيعها بها.
قسد بدورها التي تحاول الصمود عسكريا في المعركة الحالية عند سد تشرين، تحاول التواصل مع دمشق بقيادة الحكومة الجديدة لفتح مسار سياسي حقيقي “سوري سوري” هدفه بناء الثقة، والوصول إلى ما يفيد البلاد دون ربط ذلك المسار بالمصالح الداخلية لقادة دولة مجاورة كتركيا. وهذا خيار منوط بقادة دمشق على تبنيه أكثر منه قدرة لدى قسد على فرضه. الطرح القادم من قسد، ومحاولات شرحها لدمشق هي الأكثر الممكن سياسياً فعله من جانبها في حين الفعل المرتبط بقبول الطرح والعمل على بلورته سياسياً هو خيار ممكن ومتاح لحكومة دمشق، وعامل إضافي لكسب الثقة لدى سكان الثلث السوري الخارج عن سيطرتها. وهو الخيار العملي الأنسب الذي سيقوم بإيقاف نيران المعركة العبثية عند سد تشرين، ويخفف من حدة الدماء هناك، ويقلل من شحنة الشرخ الاجتماعي بين الأطراف الراغبة بتقديم صورة صراع قومي بين الأطراف المتحاربة. هذه الصورة التي تعاني من الكثير من المثالب وعدم الواقعية على اعتبار ما يقارب الثلثين من قوات قسد هي قوات عربية قادمة من عشائر عربية مختلفة وأصيلة ممتدة من شواطئ نهر الفرات إلى مضارب الحسكة.
وعلى الرغم من التمني الكردي العام بوصول تلك القافلة للسلام المنشود إلا أن قادة الإدارة الذاتية لا بد وأنهم يمنون النفس أكثر بفصل مصيرهم بمصير تلك القافلة، والبحث عن حل لقضايا منطقتهم مع دمشق، دون تداخل مع ملف قد يكون أكبر وأكثر تعقيد وإشكالية من ملفهم الواضح مع “دمشق”. دمشق التي تبحث بدورها عن الاستقرار لتجاوز مرحلة انهيار نظام الأسد وبناء الدولة من جديد. وهذا قد يخفف من الخوف العام من طبيعة علاقة حكومة دمشق مع الكرد الذين لا زالوا يعاني الكثير منهم من سنوات من الانتهاكات بحقهم في مناطق كعفرين ورأس العين ولا يملك الكثير من النازحين منهم الثقة بإمكانية العودة إلى منازلهم بعد سنوات النزوح المريرة.
ان السياق السياسي المرتبط بمصير شرق الفرات لا يمكن أن يبقى حبيس الاشتباك العبثي عند سد تشرين أو حبيس الضربات الجوية التركية للمناطق ذات الكثافة الكردية للأبد. السياق هذا يحتاج إلى مبادرة من دمشق قائمة على القدرة على استقبال الطرح القادم من القامشلي بصورة أكثر “استقلالية وحرص” على تبادل الآراء والتفاهم الهادف للصالح السوري العام. السياق السياسي هذا هدفه تحييد القضية المحلية هذه من الملفات التي تحملها تلك القافلة الجارة، والبحث عن جذورها المحلية الممتدة لعقود من الاضطهاد قاده حزب البعث. التحييد المطلوب هذا قد يعزز القدرة على بناء القدرة لدى الأطراف العاملة في سوريا على بناء أرضية قانونية وسياسية ناجعة لأهم ملف سياسي وأمني واقتصادي غير محلول حتى هذه اللحظة من قبل دمشق. الملف الذي قد يكون حله بداية لولادة لرحلة قافلة جديدة هدفها تعزيز العيش المشترك وبناء السلام والدولة بصورة أكثر استقرار ونمو في سوريا ما بعد البعث، وقد يكون نهاية لحالة عدم اليقين لدى كرد سوريا من سياسات التهميش التي عايشوها لعقود مع حكومات دمشق السابقة ودافع أكبر لهم للانخراط أكثر في الشأن العام الذي حرموا منه لعقود طويلة.
نورث برس
———————————-
=========================