فن «غير الممكن»: كيف يُعيد المسرحُ التفكيرَ بسؤال العدالة في سوريا؟/ وسيم الشرقي
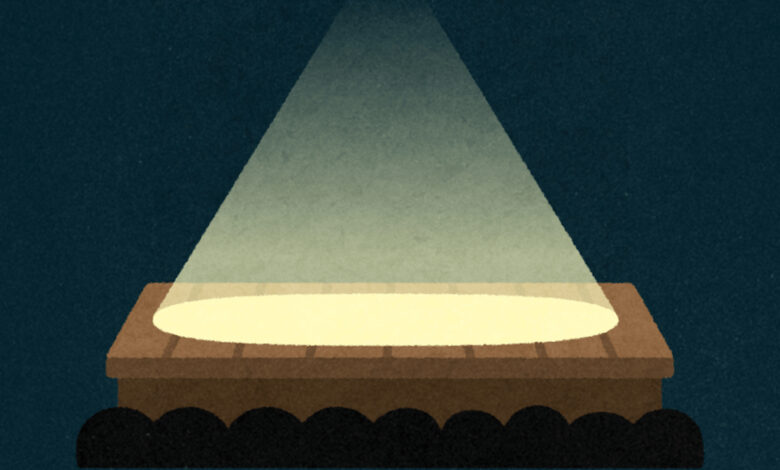
18-02-2025
منذ الأيّام الأولى لهروب الأسد، يتداول سوريّون وسوريات على مختلف وسائل التواصل فيديو قصيراً لأحمد الشرع، جالساً في الصفّ الأوّل لمسرح في مدينة إدلب، يتابع المشهد الأخير من مسرحيّة يتلو أحد ممثلّيها حُلماً رأى فيه أنّه مذيع إخباري يزفّ خبر تحرير مدينة دمشق بالكامل، ويهنئ فيه شعب سوريا العظيم بتحرير «دمشق الروح، دمشق القلب، دمشق الياسمين، دمشق الفيحاء…». على وقع هذه الكلمات تدمعُ عينا الشرع، ويمدّ يده ليلتقط منديلاً ليمسح دموعه.
الفيديو الذي انتشر كثيراً عقب التحرير الحقيقي لدمشق، يعود لمسرحيّة قصيرة عُرِضت في افتتاح الدورة الثالثة من معرض إدلب للكتاب في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، في المشهد الذي يُعرَض على الخشبة، يدور حوار في مخيّم لللاجئين السوريّين بين شابّين، الأوّل يُقرّر العودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في دمشق، بعد سنوات من العيش في المُخيّم، أما الشاب الآخر، والذي يَظهر بثياب ممزقّة وحالة بائسة، وقد وصل للتو من مناطق سيطرة النظام، يُستَفزُّ حين يسمع بقرار الشاب الأوّل، ليدخل الاثنان في حوار غاضب عن طبيعة الحياة في مناطق سيطرة النظام وضرورة الصبر حتّى إسقاطه، ليتدخّل الممثّل/المذيع ويُنهي المسرحيّة بالخطاب الذي أبكى الشرع يومها.
قُبيل نهاية العام الماضي، وفي مقابلته الأولى مع محطّة عربيّة، يُجيب الشرع عن سؤال المذيع حول إمكانيّة حضوره لـ«مسرحيّة ملتزمة تنتقده» بأنّه الآن «لا يجد الوقت للنوم»، وبإنّه سيستغلّ الوقت إن وُجِد بالراحة، لينتشر هذا الجزء من المقابلة مثل الفيديو القديم من معرض إدلب للكتاب، ويتحول إلى عنوان للاستوديو التحليلي حول كلام الشرع على قناة العربية، وإلى موضوع لردٍّ من عميد المعهد العالي للفنون المسرحيّة بدمشق، يقول فيه إن التفاعل الواجب مع كلام الشرع هو دعوته لحضور مسرحيّات في المعهد.
في كلتا اللحظتين، لحظة معرض إدلب للكتاب، ومقابلة قناة العربيّة، يحمل المسرح رمزيّة معيّنة؛ الأولى تتعلّق بتفاؤل مُهجَّري وأهل إدلب بتحرير سوريا رغم التشاؤم الذي كان سائداً وقتها، والثانية تتعلّق بالطبيعة المحتملة للحكم الجديد في دمشق، خاصّة فيما يتعلّق بالفنون والثقافة، وذلك وسط تخوّفات من قيود محتملة للحكّام الجدد على القطّاع الفنّي، وغياب الوضوح حول رؤية الإدارة الحاليّة للفن ومؤسساته في سوريا.
ولكن ماذا لو ابتعدنا قليلاً عن دموع الشرع في إدلب عند ذكر دمشق الياسمين، وعن ابتسامته الدبلوماسيّة المُتعَبة في قصر الشعب في دمشق حين سؤاله عن المسرح، وسألنا كيف يمكن تَخيُّل شكل المسرح السوري في سوريا ما بعد الأسد؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الفن السهل الممتنع في سوريا الجديدة؟
«ميزةُ المسرح التي تجعله مكاناً لا يُضاهى، هي أن المتفرِّج يكسرُ فيه مَحّارته، كي يتأمل الشرط الإنساني في سياق جماعي يوقظ انتماءه إلى الجماعة، ويُعلَّمه غنى الحوار وتَعدُّد مستوياته. فهناك حوار يتم داخل العرض المسرحي، وهناك حوار مُضمَرٌ بين العرض والمتفرج. وهناك حوار ثالث بين المتفرجين أنفسهم. وفي مستوى أبعد، هناك حوار بين الاحتفال المسرحي، عَرضاً وجمهوراً، وبين المدينة التي يتم فيها هذا الاحتفال. وفي كل مستوى من مستويات الحوار هذه ننعتقُ من كآبة وحدتنا، ونزداد إحساساً ووعياً بجماعيّتنا. ومن هنا، فإن المسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني فحسب، بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع، وضرورة من ضرورات نموه وازدهاره».
في رسالته في يوم المسرح العالمي قبل قرابة الثلاثين عاماً، يحلم الكاتب المسرحي السوري الراحل سعد الله ونوّس بدورٍ للمسرح في حياة مجتمعاتنا المعاصرة، يُعزِّز فيها هذا الأخير دور الحوار، الحوار المركّب والمتعدّد. ورغم كتابة ونّوس للكلمة أثناء مقاومته لمرض السرطان، ورغم وعيه يومها بالحال البائسة التي وصل إليها المسرح قُبيل نهاية القرن الماضي، وبأَخطار «الشاشات الملوّنة والتفاهات المعلّبة»، يؤكد في جملته الشهيرة على أنّنا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ.
في الأسابيع الأخيرة عُدنا كسوريّين للتذكّر بأنّنا فعلاً محكومون بالأمل، وأنّ حُكْمَ الأبد لم يكن نهاية التاريخ، لكن ما الذي يمكن فعله اليوم بالإضافة إلى التحلّي بالأمل القادر على إحياء القدرة على العمل، وأيّ دور يمكن أن يلعبه المسرح في سوريا اليوم؟
المسرح والعدالة
حديثُ المسرح ذو شجون، سواء كان مع مُخرِجة مسرحيّة في برلين أو كاتب مسرحي في نيويورك، وخاصّة في لحظتنا الحاليّة، وسط تراجع الاهتمام بالفنون حتّى في أكثر دول العالم غنى، وصعود كبير لحكومات يمينيّة تُقلِّص تمويل الفنون وعلى رأسها المسرح.
وبطبيعة الحال، فالأمر أسوأ بمراحل عند الحديث عن المسرح في سوريا، في البلد الخارج تواً من عقود تحطيمٍ للمجتمع، وغياب لحقوق التجمّع والتفكير بصوت مرتفع، ومركزيّة شديدة بالعلاقة مع المؤسّسات الثقافيّة والفنيّة، والكثير الكثير من الفساد والإفساد، والفقر في الإمكانيّات وربما أيضاً في المُخيّلة.
ولكن رغم ذلك كلّه، ورغم ضبابيّة اللحظة الحاليّة سياسيّاً، وبؤس الإمكانيّات والتشرذم الكبير للمسرحيّين والمسرحيّات السوريّين، تبدو اللحظة الحاليّة حُبلى بالكثير من الفرص التي يمكن للمسرح أن يستغلها ليلعب دوراً في سوريا في المستقبل، أو حتّى في الحاضر، وعلى الفور.
أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في سوريا اليوم هو سؤال العدالة، العدالة الانتقاليّة، غير الانتقاليّة، سَمِّها ما شئت، لكنّ السوريّات والسوريّين اليوم بحاجة، بعد رغيف الخبز وضوء المصباح وجرّة الغاز، إلى شكل من أشكال المحاسبة، للصفح والمسامحة وطَيّ صفحة الماضي ربما، لكنّهم بحاجة للنظر إلى تلك الصفحة مليّاً، والتأمّل فيها وتعلّم دروسها، وخلق معنى ما من مأساتها. الطريق المضمون نحو خراب قادم هو إخفاء صفحة الماضي تحت السجّادة، والاستمرار بالحياة وكأنّ شيئاً لم يكن.
دوناً عن الفنون الأخرى، يحمل المسرح في سوريا اليوم إمكانيّة كبيرة للَمس أسئلة العدالة المُلحّة، للتفكير فيها بصوت عالٍ، للحديث عنها مع السوريّين في سوريا، في كلّ مدنها وقُراها، وربّما في مدن وقرى العالم أجمع. أقول المسرح دوناً عن الفنون الأخرى، بسبب طبيعة الفنّ المسرحي على المستويين التقني والفكري.
فعلى المستوى التقني، يتميّز المسرح مقارنة مع فنون دراميّة أخرى، مثل السينما والتلفزيون، بالخِفّة والعمليّة في حال وجود الإرادة لصنعه. بإمكانك طبعاً أن تُنتِج مسرحيّة بمئات الآلاف من الدولارات، وبإمكانك أيضاً أن تُنتج مسرحيّة دون أيّ مقوّمات، يكفي أن يكون لديك مؤدٍّ ومُشاهد واحد ليكون لديك مسرحيّة، والتجربة السوريّة في السنوات السابقة مليئة بالأمثلة على محاولات صنع مسرح من اللاشيء تقريباً، سواء في المدن والأحياء المحاصرة، أو في مخيّمات اللجوء، أو حتّى في المعتقلات والسجون.
التراث المسرحي العالمي مليء أيضاً بالنماذج والتنظير لأشكال مسرحيّة «فقيرة» من حيث الأدوات وكبيرة من حيث التأثير، مثل المسرح الفقير ومسرح المضطهدين، وغيرها الكثير.
عقب سقوط النظام، كان المسرح أوّل وسيط فنّي ينتقل من الشتات السوري إلى داخل سوريا، وذلك ليس عبر وسائط تقنيّة كالفيديو أو الصوت أو الصورة، على أهميّتها، وإنّما عبر الجسد الحيّ لمؤديّه. على الأقل لدينا مثالان: الأوّل مسرحية المُهاجران للأخوين ملص على خشبة مسرح الخيّام في دمشق، إحدى خشبات المسرح «القومي»، والثاني مسرحيّة رح نبنيها على مسرح نقابة الفنّانين في حلب، من أداء يمان نجّار وسمير أكتع ومحمد جعفر وقمر الزمان برو.
وبغض النظر عن «السويّة الفنيّة» للعرضَين اللّذين لم يشاهدهُما كاتبُ هذه السطور، وعن الجدل الذي أحدثاه في أوساط المتابعين والمهتمين بالمشهد المسرحي، فإن المثال هنا عن الطبيعة الخاصّة للمسرح بالمقارنة مع فنون أخرى أكثر بُطأً من حيث سيرورتها، وتحتاج وقتاً وإمكانيّات أكبر بكثير للإنتاج.
أمّا على المستوى الفكري، وهو الأهم هنا، فالمسرح في سوريا يحمل اليوم إمكانيّة كبيرة للحديث عن كلّ ما جرى ويجري، حيث تُشكّل طبيعة الفنّ المسرحي القائمة على عرض الصراعات والتناقضات البشريّة على الخشبة، مساحة ضروريّة لعرض صراعاتنا السوريّة، وما أكثرها!
في أثينا القديمة لعب المسرح دوراً «تطهيريّاً» للجمهور الأثيني وفق التعبير الأرسطي. كان الجمهور يعيش خلال المسرحيّات الصراع بين الآلهة والبشر، الأبطال التراجيديّين، والذي ينتهي دائماً بفوز مشيئة الآلهة، وبنهاية فجائعيّة للبشر الممثَلّين على الخشبة. بعد كل عرض كان يخرج الجمهور، وفق أرسطو، بحالة من التطهير Catharsis أو التنفيس، بعد أن عاش لساعات مع الممثلين على الخشبة مشاعرَ مُركَّبة مثل الخوف والشفقة، فيخرج من المسرح مُتخفِّفاً من هذه المشاعر.
بعد أكثر من ألفي عام، قام الكاتب والمخرج الألماني برتولد بريشت بثورة على مفهوم التطهير الأرسطي، لينجز نظريّته عن المسرح الملحمي الذي كان ثورة على مفهوم التطهير الأرسطي، حيث رأى أن دور المسرح يكمن أيضاً في مخاطبة عقل المتفرّج، لا مشاعره فقط، وذلك بهدف فتح عينيه على الظروف السياسيّة والاقتصاديّة التي يعيش فيها، وربّما زرعِ نواة الثورة في داخله.
وسواء كان الصراع في المسرح بين الإنسان والآلهة، أو بين البشر وظروفهم الطبقيّة والسياسيّة، فإنّ الصراع مكوّن أساسي في الفنّ المسرحي، فالمسرح، وعبر تاريخه، كان قادراً دوماً على عكس الصراعات والتناقضات وإظهارها على الخشبة، دون الحاجة إلى تقديم اقتراحات لحلّ هذه الصراعات بالضرورة، فإن كانت السياسة بإحدى تعريفاتها هي «فن الممكن» فإنّ المسرح السوري اليوم قد يكون فنّ «غير الممكن»، أي مكان عرض الصراعات والتناقضات غير القابلة للحل، ولكن القابلة للتأمّل والتفكير، والشعور أيضاً.
مظلوميّة ومركزيّة
لا يخفى على أحد حجم الفوضى التي يتم التعامل بها اليوم مع أكثر الملفّات السوريّة أهميّة وحساسيّة: الاعتقال والإخفاء القسري، السلم الأهلي والعدالة الانتقاليّة، الاعتراف بالجرائم والمأساة، محاسبة المجرمين، وعشرات القضايا المُلحّة الأخرى. ومن تلك القضايا قضيّة الإحساس بالظلم عند قطّاعات واسعة خسرت كلّ ما تملكه في سنوات الثورة، حيث عانى كلّ السوريّين من الظلم والقهر والخوف تحت حكم الأسدين؛ لكن هل كانت الأثمان التي دفعتها المجتمعات السوريّة واحدة؟
المظلوميّة التاريخيّة بسبب أحداث قريبة أو بعيدة في التاريخ كانت دائماً وقوداً لأبشع الانتهاكات والجرائم في سوريا، ليست تجربة السوريّين واحدة في سنين الثورة أو حتى قبلها، والتعامي عن الفروقات بين ما جرى للمجتمعات السوريّة المختلفة لا يَعِدُ بكثير من العدل والفهم والسلم الأهلي في المستقبل، خاصّة إذا استمرّ التعامل مع هذه الملفّات بالخفّة والفوضى التي نعيشها اليوم.
للفنون السوريّة، وخاصّة الدراما التلفزيونيّة، تاريخ سيّء في تصوير المجتمعات السوريّة خارج المدينة، أو ربّما خارج دمشق تحديداً مع استثناءات قليلة، ولا يصعب على المراقب رؤية كميّة التسطيح والاختزال للمجتمعات الريفيّة السوريّة في الدراما التلفزيونيّة، الأمر الذي قيلَ فيه كلامٌ كثير.
السؤال اليوم، هل هذا التصوير المُجحِف والمُختزَل، نتيجة لعقليّة سيّاسيّة وثقافيّة مُعيّنة، سيتغيّر اليوم جذريّاً مع انطواء صفحة الأسد؟ أمّ أنّ العلاقة الملتبسة بين المركز و«الأطراف» في الفنّ السوري هي نتيجة بنيّة معقّدة لا يكفي الوعي بوجودها لتغييرها اليوم إلى غير رجعة.
بالعودة إلى «الخِفّة» التي يتمتّع بها المسرح، الفرصة متاحة اليوم ليلعب المسرح، دوناً ربّما عن فنون أخرى، دوراً في رفع العبء الثقيل لتاريخ المركزيّة الفنيّة والثقافيّة في سوريا، ولفتح حوار في مجتمعات ومدن وبلدات وقرى أُشعِرَ سُكّانها على مدى عقود أنّ حياتهم وآراءهم ليست جديرة بالنقل إلى خشبات المسارح وشاشات التلفاز، وأنّ حياتهم نفسها ليست مُهمّة في حال اعترضوا على الطريقة التي يُحكَمون بها. الحوار المُركَّب الذي يخلقه المسرح وفق تعبير ونّوس، هو ضرورة اليوم لبناء مجتمع سوري جديد على أنقاض المجتمع المشوّه الذي ورثناه من سوريا الأبد.
هل يبدو الكلام السابق مُفرِطاً في التفاؤل بدور المسرح في ظلّ الواقع السوري الحالي؟ وفي ظلّ مخاوف مشروعة من إمكانيّة إغلاق باب الفنون كلّه إلى غير رجعة من قبل الحاكمين الحاليّين؟ ربّما، لكن كما في عبارة ونوّس الشهيرة التي كانت يوماً على حيطان مدينة سراقب، فإنّنا ما زلنا محكومين بالأمل، وربّما لا نملك تقريباً أيّ شيء سواه في سوريا اليوم.
موقع الحمهورية




