هل للرواية رؤية للعالم؟/ حسونة المصباحي
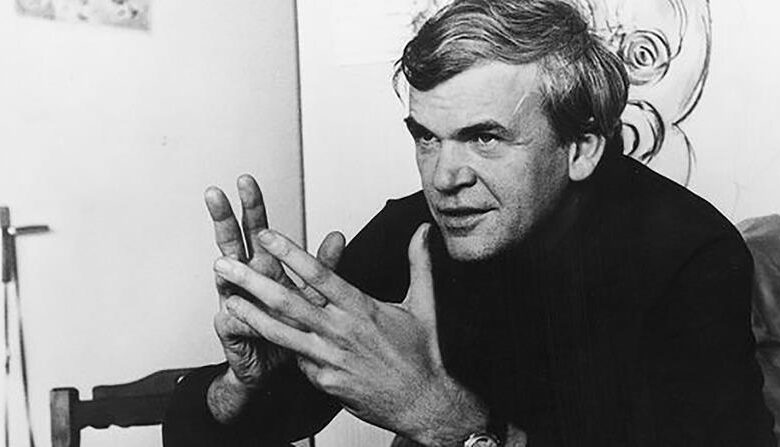
18 فبراير 2025
في محاضرة له بعنوان “رؤية العالم من خلال الرواية”، يُشير الروائي النمساوي هرمان بروخ (1986- 1954)، صاحب رائعة “موت فرجيل”، إلى أن الرواية لها رؤية للعالم مثلها مثل العلوم والفلسفة. ومثل الفلسفة الوجودية التي عرفت رواجًا واسعًا في النصف الأول من القرن العشرين، تركز الرواية الحديثة مع مبدعيها الكبار من أمثال مارسيل بروست، وجيمس جويس، وفرجينيا وولف، وفرانز كافكا، وويليام فوكنر، وصاموئيل بيكيت، على الفزع الذي هو في الآن نفسه سيكولوجي وميتافيزيقي. وهذا الفزع يُصيب الإنسان الحديث تجاه الحياة التي تزداد تعقيدًا وقسوة تزامنا مع التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي، وتحكّم الاستهلاك الجنوني في المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء. كما يصيبه في الصميم عندما يشعر أنه وحيد حتى في المدن الكبيرة الصاخبة، وأنه قد يموت في أية لحظة جراء الأمراض المعضلة التي استفحلت في عصره. والفزع من الموت هو أيضًا موضوع أساسي في الرواية الحديثة. وعن ذلك، كتب هرمان بروخ قائلًا: “وسيطًا بين الواقع السيكولوجي والميتافيزيقي، يكون الموت خطّ الذروة بين عالم الوعي المُضاء، حيث الأشياء معروفة، ولها أسماء، ويمكن تحديدها وتوصيفها، وعالم الظلمات حيث لا شيء يمكن أن يُحدد ويوصف، منه يأتي الغمّ والمأساة، وأيضًا المأساة التي لا اسم لها في المعنى الحقيقي للكلمة. وهذه المأساة تنتظر خلاصها بواسطة الكلمة المحددة لها لكي تُعرف، ولكي نكون نحن معصومين سحريًا تجاهها”.
وهذا الموت لا يخصّ الإنسان فقط، بل هو يخصّ القيم والأفكار والرؤى والتطلعات والآمال التي جاءت بها فلسفة ديكارت العقلانية، وفلسفة الأنوار التي بشّرت بخلاص الإنسانية من الظلم والاستبداد والتزمت الديني، والفلسفة الوضعية التي مجّدت التقدم الذي يضمن السعادة للبشرية جمعاء، والفلسفة الماركسية التي جعلت من تقويض الفروق بين الطبقات شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية. كل هذه الفلسفات وجدت نفسها في حيرة أمام عالم مزقته الكوارث والحروب والنزاعات والأيديولوجيات، فبات بلا سمات ولا معالم تُرشد الإنسان إلى طريق الخلاص. وقد سعت الفلسفة الوجودية التي برزت مع كل من كارل ياسبرس وهايدغر إلى إضاءة الصورة المخيفة للعالم الحديث. إلاّ أنها ظلت تجريدية، ومنحصرة في دوائر أكاديمية. أما الرواية فقد تمكنت من أن تعبّر، عبر شخصياتها القلقة والمضطربة والحائرة، عن الواقع المرير الذي أصبحت تتخبّطُ فيه البشرية رغم ما حققه التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي. وهذا يتجلى لنا في الروايات الفكرية والفلسفية مثل “الجبل السحري” لتوماس مان، و”السائرون نياما” لهرمان بروخ، و”رجل بلا مواصفات” لموزيل. وهناك روايات أخرى لم تكن مثقلة بالأفكار والنقاشات الفلسفية مثل الروايات التي ذكرت، ولم يدّعي أصحابها أنهم مُلمون بالفلسفات القديمة والحديثة، إلاّ أنها جاءت مُحمّلة بما يساعد الإنسان على السير مترنحًا في ظلمات عصر مضطرب ومتقلب ومحفوف بالمخاطر الجسيمة. ولعل شوبنهاور ونيتشه هما الملهمان الكبيران لمبدعي هذه الروايات. وفي “المسيح الدجال”، كتب نيتشه يقول: “ما وراء الشمال، والجليد، والموت، تكمن حياتنا. وسعادتنا (…) لقد اكتشفنا السعادة، ونحن نعرف الطريق، وقد عثرنا على مخرج متاهة تمتد إلى آلاف السنين. هل وجدها أحد آخر؟ هل يكون الإنسان الحديث؟ إلاّ أن الإنسان الحديث يئن متوجّعًا قائلًا: “أنا لا أدري إلى أين أذهب، وإلى أين أجيء” (…). نحن كنا مرضى بهذه الحداثة، وبالسلام الوسخ والمتعفن، وبالتسوية الجبانة، وبالالتباس الحديث والفاضل لنعم ولا. هذا التسامح، وهذا “القلب الكبير” الذي يغفر لأنه “يفهم” كل شيء، هذه هي ريح السموم بالنسبة لنا. إن العيش في الجليد أفضل لنا من كل هذه الفضائل الحديثة، ومن كل رياح الجنوب”.
أبطال هذه الروايات الحديثة أناس عاديّون تسحقهم الحياة برتابتها اليومية وبالأوهام التي تبشرهم بالسعادة والأمان والعيش الكريم. وليس من الصدفة أن يختار جيمس جويس “عوليس” عنوانًا لروايته الشهيرة. و”عوليس” هنا ليس البطل اليوناني الأسطوري، والمحارب الشجاع، والمغامر الجسور الذي عاش مغامرات رهيبة في البحر واجه خلالها الموت أكثر من مرة، بل هو موظف بسيط في وكالة للإشهار في دبلن، يُدْعى ليوبولد بلوم. وخلافا لبينلوبي التي ظلت تنتظر عودة زوجها عوليس على مدى عشرين عامًا، فإن “مولّي” الشبقة والشهوانية لا تتردد في خيانة زوجها على مرأى ومسمع منه. ويقضي ليوبولد بلوم يومًا كاملًا يحضر في بدايته جنازة أحد أصدقائه، ثم يشرع في التسكع في شوارع دبلن، وعلى الشاطئ، وفي التنقل بين الحانات. وفي نهاية الليل يجد نفسه سكرانًا في محل للبغاء… ظاهريًا، ليست هناك أية أحداث مثيرة، ولا مغامرات عجيبة. لكن حين نتعمّق في قراءة هذه الرواية الضخمة، نُعاين أن جيمس جويس أخذنا بهدوء إلى أعماق الحياة المعاصرة مضيئًا لنا عتمتها، وكاشفًا عن الكثير من أسرارها وخفاياها المرعبة التي تصيبنا بالدوار والغثيان عند الإطلالة عليها.
وكان جيمس جويس قد تأثر في سنوات شبابه بالفيلسوف الإيطالي جيامباتيستا فيكو (1686- 1744) صاحب الكتاب الشهير “العلم الجديد” الذي طرح فيه العناصر الأساسية لفلسفته المناهضة لفلسفة ديكارت العقلانية التي كانت رائجة في عصره. وكما هو معلوم، كان العقل بالنسبة لصاحب “خطاب الطريقة” هو المرشد والدليل، وهو “المنقذ من الضلال”، والهادي إلى حقيقة الحياة والوجود. إلاّ أن فيكو كان معارضًا لخطاب ديكارت، ومتناقضًا معه. بل إنه كان يعتبره خطرًا على الخيال وعلى الحساسية، وعلى العواطف والمشاعر الإنسانية. وقد اتهم فيكو معاصريه من أتباع ديكارت بـ”حشو رؤوس” الشباب بكلمات كبيرة، وبأفكار تقودهم إلى عالم بارد، وإلى ما سمّاه بـ”البربرية الفكرية”. وفي روايته “عوليس” أراد جيمس جويس أن يبرز لنا أن العقلانية الجافة والباردة يمكن أن تحرمنا من فهم الحياة في جوانبها وتجلياتها المختلفة والمتعددة، لذا يجدر بنا أن نعير الميثولوجيا والأساطير اهتمامًا لأنها من ابتكار خيال الشعوب، وبالتالي هي قادرة على أن تضيء لنا ظلمات الوجود الكثيفة، المتراكمة حولنا مانعة عنا حتى رؤية الأفق القريب. وأعتقد أن الروائيين المحدثين الكبار الذين أشرت إليهم سابقًا، والذين تغذّوا من الأساطير القديمة، سعوا إلى أن تكون أعمالهم عاكسة لعصرهم الذي خلت منه الأسطورة، والبطولة. وفي هذا السياق، كتب الألماني غونتر غراس صاحب رائعة “طبل الصفيح” يقول: “إن الأدب يتغذّى من الأسطورة. وهو يبتكرُ أساطير، ويحطم أخرى. وفي كلّ مرة، يروي الحقيقة بطريقة مُغايرة. وذاكرته تُحيلنا إلى ما يتوجّب علينا أن نتذكره. وربما نتوصّلُ ذات يوم أن يكون بعيدًا، وهذا ما أتمناه، إلى أن نفكر من جديد بالصور وبالدلالات لأننا نسمح لعقلنا بأن يؤمن بالحكايات، وأن يلعب مثل مُهرج بالأرقام وبالدلالات والمعاني، وأن ندع خيالنا يمضي على هواه إلى أبعد ما يكون، وأن نعترف بأننا إذا ما بقينا على قيد الحياة، فإن الفضل يعود إلى الصرامة في الأساطير، حتى ولو تمّ ذلك من خلال الأدب”.
***
وفي رواياته، اهتم فرانز كافكا بوصف وانتقاد العالم العبثي المفارق الذي يتجسد في المجتمعات البيروقراطية، وفي الأنظمة الشمولية. فَعَل ذلك قبل حنه أرندت ومفكرين وفلاسفة آخرين اهتموا بالأنظمة الفاشية والنازية والاستبدادية. غير أن صاحب “المحاكمة” يذهب بنا إلى أبعد من ذلك. وعلى السؤال التالي: “قل لي كيف تعيش في هذا العالم الذي أنت تتحدث عنه؟”، هو يُجيب قائلًا: “بفضل أجوبتي، أنا قادر على أن أرضي الحشد الذي يتزاحم ليكون على اتصال معي (…) وصحيح أنني لا أفهم دائمًا ماذا تريدون أن تعرفوا، إلاّ أن هذا ليس ضروريًا”. وفي الفصل الشهير في رواية “المحاكمة” والذي بعنوان “أمام القانون” يتجلى لنا أن المصير الذي يعني عند كافكا “القانون”، مفروض على الفرد الضائع في مجتمع لا يسمعه ولا يراه، وحتى إن سمعه فهو لا يفهم ما يقول، وإن رآه يكون شبحًا مبهمًا وغائمًا بلا هوية وبلا مواصفات تدل على أنه من بني آدم. والفصل المشار إليه يؤكد أيضًا أن الأسئلة التي يطرحها ك. الشخصية الرئيسية في “المحاكمة” لا تجد لها جوابًا، بل تفضي إلى مزيد من الأسئلة الأخرى التي قد تكون أشدّ تعقيدًا من الأولى. وحتى عندما يكون هناك جواب فإنه يكون بمثابة الباب الذي يُفتح ثم يُغلق بسرعة. وتكون عداوة المجتمع المغلق للشخص الذي يتجرأ على طرح أسئلة شديدة إذ أنه يعتبر هذه الأسئلة حيلة شيطانية، لكشف ما هو مخبوء، وما هو مستور، واعتداء صارخًا على “قانون” له صفة المقدّس. إن استحالة العثور على أجوبة في مجتمع يكون فيه “القانون” مصير الجميع، يُشبه إلى حد كبير استحالة الحركة عند الفيلسوف الرواقي زينون (334-262 ق. م). فقد كان العدّاء السريع أخيل يتهيأ للمشاركة في سباق للجري في مهرجان “باناثينا” الرياضي لما جاءه زينون ليقول له بأنه قبل أن يصل إلى نقطة النهاية، يتعيّنُ عليه أولًا أن يمرّ بمنتصف الطريق. وقبل أن يصل إلى منتصف الطريق، لا بد أن يقطع مسافة ربع الطريق، ولكي يقطع هذه المسافة أيضًا، لا بد أن يقطع مسافة ثمن الطريق. وحين سمع أخيل هذا الكلام، أصابه القلق والحيرة لأن عملية التفكير هذه قد تستمرّ إلى ما لانهاية. وبذلك عدل عن المشاركة في سباق الجري بعد أن أقنعه زينون بأنه لا فائدة تُرجى من الحركة… وفي رواية “المحاكمة” يكتفي الحراس ورجال الشرطة والموظفون في أجهزة القضاء بالردّ على ك. بأنه لا جدوى من طرح الأسئلة. وفي النهاية يساق إلى حديقة فارغة ليتلقّى طعنة الموت.
وفي قصة “الخذروف” يطرح كافكا مسألة استحالة وصول الفلسفة إلى الحقيقة تمامًا مثلما هي الحال بالنسبة للأدب. الشخصية الرئيسية في هذه القصة، فيلسوف يستهويه التجول قرب الفضاءات التي يُمارس فيها الأطفال شتّى ألعابهم. وحين يرى طفلًا يلعب بخذروفه، يتوقف عن السير لمراقبته وترصّده. وهو يندفع للإمساك بالخذروف حالما يشرع هذا الأخير في الدوران. لكن عند الإمساك بالقطعة الخشبية الصغيرة، يشعر بالغثيان. عندئذ تتعالى صيحات الأطفال الساخرة من كل ناحية مُجبرة إياه على الفرار مترنحًا كما لو أن سياطًا تضرب ظهره. ويبدو الغرض من هذه القصة هو أن الفيلسوف يكون دائمًا في بحث مستمر وبلا نهاية عن حقيقة الإنسان والأشياء، والفلسفة قد تتوصل إلى كشف جزء صغير من الحقيقة الكونية، إلا أنها سرعان ما تكتشف أن الطريق لا يزال شائكا وطويلا، وأن البحث عنها يتطلب المزيد من الجهود المضنية.
***
في سيرته الذاتية “تقرير إلى غريكو”، حدّد نيكوس كازانتزاكيس الذين تركوا آثارًا عميقة في نفسه وهم هوميروس وبوذا ونيتشه وبرغسون وزوربا. فالأول كان بالنسبة له “العين الأخاذة، مثل قرص الشمس الذي يُنير الكون ببهائه الشافي”. وبوذا هو “العين القاتمة العميقة الغور التي غرق العالم فيها ثم نجا”. وقد ساعده برغسون على الخلاص من العديد من الإشكاليات الفلسفية التي حيّرته، والتي كانت تقضّ مضجعه في أيام الشباب. وعلّمه زوربا أن يحبّ الحياة، وأن لا يخاف من الموت. أما نيتشه فقد أغناه بـ”عذابات جديدة، وعلّمه كيف يُحوّل الفشل والمرارة والشك إلى كبرياء”. وقد وصف كازانتزاكيس اكتشافه لنيتشه الذي وصفه بـ”الشهيد العظيم”، بـ”اللحظة الحاسمة في حياته”. وقد حدث هذا الاكتشاف في باريس أيام الدراسة في جامعة “السوربون”. وفي كل ليلة، في غرفة الطالب الضيقة، كان يتصفح كتبه المكومة أمامه لـ”يشاركه في كفاحه”. وشيئًا فشيئًا “تعوّد على صوته، وعلى نَفَسه اللاهث، وعلى صرخاته المتألمة”. ومن فرط إعجابه به، انطلق كازانتزاكيس ليزور كل الأماكن التي وطأتها قدما “الشهيد العظيم” بعد أن تخلى عن التدريس، وترك ألمانيا “المتجهمة والعابسة” ليتسكع في نيس، وفي جنوة، وفي أماكن أخرى حيث الضوء الساطع والهواء النقي. وفي تلك الأماكن التي لجأ إليها هربًا من كوابيسه المرعبة، لم يكن يبتغي شيئًا آخر غير أن يكون وحيدًا، مستسلمًا لأحلامه ولأفكاره التي من لهب. ويرى كازانتزاكيس أن نيتشه في هذه الفترة لم يعد يرغب في أن يكون الفيلسوف الصارم الكئيب الذي يسعى عبر المفاهيم إلى إدراك سر الحياة والوجود، بل كان يحلم بأن يكون الشاعر الذي يرقص حرًا طليقًا على أنغام كل كلمة تنفجر في داخله. لذلك كتب يقول: “ما الذي يعنيني من المبادئ الأخلاقية؟ افعل هذا ولا تفعل ذلك؟ كم يختلف عنها البرق والعاصفة والبرد -القوى الحرة الخالية من التعاليم الأخلاقية- كم هي سعيدة وقوية تلك القوى التي لا يزعجها الفكر”. ويُشير كازانتزاكيس إلى أن نيتشه جعله يُطلّ على هاوية العدم. وفي البداية ارتعب وأصابه الدوار، وظلت روحه قلقة ومضطربة. لكن شيئًا فشيئًا، استطاع أن “يقف، وركبتاه ثابتتان، على حافة الجرف، ويتطلّعُ إلى الهاوية بدون خوف أو أثر للتبجح”. وعن التأثيرات الفلسفية في أعمال صاحب “زوربا اليوناني”، كتب لومبروس كولوبارتسيس في دراسة له بعنوان “الشك واليقين عند كازانتزاكيس” يقول: “هؤلاء المفكرون جمعهم كازانتزاكيس بطريقة خفية ومُضمرة مع الجوانب الأربعة لفكره لتغذية وتحريك تمفصل حيويته الخلاقة. والرواية التي تستمدّ نسغها من الواقع المُعاش ومن عذاب الإنسان، تكون وسيلة لانبثاق عنصرين أساسيين في فكره، اللهب والصرخة اللذان يختفيان داخل الإنسان. اللهب والصرخة كمظهرين لأعماق الإنسان التي بلا عمق يجمعان القوة الضرورية لتحريك النضال من أجل الحرية. لذلك فإن قابلية تقبّل هذا اللهب، والإنصات الدائم لهذه الصرخة، يُنشئان الشرط نفسه لتحقيق ما يستحق الاهتمام. من هنا فكرة كازانتزاكيس التي تقول بأن الفضيلة الأكبر ليس في أن يكون الإنسان حرًا، وإنما في النضال من أجل الحرية”…
***
ويُجمع كبار النقاد على أن ميلان كونديرا أفضل من فضح ألاعيب وحيل وأكاذيب الأنظمة الشيوعية في أوروبا الوسطى، وقوّض دعائم عقلانية باردة ومزيفة جعلت منها الأحزاب الشيوعية والبيروقراطية وسيلة لترويض الشعوب، وتدجينها وإرضاخها لسيطرتها المطلقة. وقد سطع نجم كونديرا في مجال الرواية على المستوى العالمي بعد أن أصدر ثلاث روايات يُدين فيها حياة أبناء وطنه في ظل الاستبداد والطغيان الشيوعي. وهذه الروايات هي “المزحة”، و”غراميات مضحكة”، و”الحياة في مكان آخر” التي أحرزت جائزة “ميديسيس” الفرنسية المرموقة وذلك عام 1973. وعن هذه الرواية كتب يقول: “لقد اخترت العنوان من بيت لرامبو. “الحياة في مكان آخر” كان طلبة ثورة ربيع 68 قد كتبوها على حيطان باريس كواحد من الشعارات التي رفعوها في تلك الفترة. و”الحياة في مكان آخر” هي وهم من الأوهام الأبدية للشبيبة، ولأولئك الذين لم يتمكنوا من تجاوز الحدود الفاصلة بين سن الشباب وسن الكهولة. وهي تعبير عن الرغبة الجامحة في الدخول إلى مملكة الحياة الحقيقية. ومثل هذه الرغبة تتطلب أفعالًا من قبل الشبان الثوريين، ومن قبل الشعراء الشبان”. ويواصل كونديرا حديثه عن روايته المذكورة قائلًا: “قبل أن أكتب هذه الرواية، قرأت الكثير من سير الشعراء. وجميعها كانت تكشف بشكل جليّ عن غياب الأب القوي. لذا يمكن القول إن الشاعر يخرج من بيوت النساء. وهناك أمهات يُفرطن في حماية شاعرهن الشاب مثل والدة ألكسندر بلوك، أو ريلكه، أو أوسكار وايلد، أو والدة الشاعر التشيكي الثوري فولكر الذي كانت سيرته عوْنًا مُهمًّا لي أثناء كتابة روايتي. وهناك أمهات باردات لكنهن ليس أقل حرصًا على حماية أبنائهن الشعراء من الأمهات اللاتي ذكرت. عندئذ ابتكرت هذا التعريف للشاعر: إنه شاب تقوده أمه. وهو يعرض نفسه على العالم الذي لا يعرف كيف يدخله”.
وفي منفاه الفرنسي أصدر ميلان كونديرا روايتين حققتا له شهرة عالمية واسعة هما “كتاب الضحك والنسيان”، و”الكائن الذي لا تحتمل خفته”. وتقوم أغلب الروايات المذكورة على كلمات أساسية مثل الجهل، والنسيان، والضحك، والخلود، والدوار… كما تقوم على الجمع بين الأحداث والأفكار والتأملات الميتافيزيقية والفلسفية العميقة. ويعني ذلك أن كونديرا تمرّد على الأشكال المتعارف عليها، والسائدة في الرواية الأوروبية ليبتكر شكلًا جديدًا مستوحى من روائيين سبقوه أمثال ديدرو، وفلوبير، وكافكا، وموزيل، وهرمان بروخ، وغومبروفيتش…
وفي الروايات التي كتبها في منفاه الفرنسي، يحضر المنفى بكل تجلياته ومعانيه الفلسفية العميقة. ففي “كائن لا تحتمل خفته”، هو يكتب: “الذي يعيش خارج بلده، يمشي في فضاء فارغ فوق الأرض تحت شبكة الحماية التي تمدها إلى كل كائن بشري ، البلاد التي هي بلاده، حيث عائلته، وزملاؤه، وأصدقاؤه، وحيث يمكن أن يُفْهَمَ من دون أيّ مشقة في لغاته التي يعرفها منذ طفولته”. وعندما يصل إلى البلد المُضيف، يشعر المهاجر بحنين جارف إلى وطنه لأنه خرج من حضن اللغة الأم ليجد نفسه في عالم غريب شبيه بالفراغ، بل بالعدم. وهذا الحنين بحسب كونديرا “لا يوقظ ذكريات، بل هو يكتفي بنفسه، وبالمشاعر والأحاسيس التي يثيرها، غارقًا في آلامه وأوجاعه”. وفي روايات المنفى، تجسّد الشخصيات التي ابتكرها كونديرا خصوصيّات أولئك الذين فرّوا من الأنظمة الشمولية، وليس أوضاع المهاجرين الذين أجبرتهم ظروف اقتصادية أو تاريخية على ترك بلدانهم للعيش في بلدان آمنة وغنية.
ويمكن القول إن كونديرا المتأثر بديدرو إلى درجة أنه يعتبر أن هذا الأخير معلمٌ له، لم يكتف برواية قصص حب رائعة، أو برسم صورة مرعبة عن الأنظمة الشيوعية الشمولية، بل هو تعدّى كل ذلك ليساهم بشكل كبير في إحداث “ثورة” في مجال الكتابة الروائية. ورواياته ليست فقط قصصًا، وإنما هي أيضًا تحليل نقدي عميق للتاريخ والمجتمعات، وللنفس البشرية. لذلك وصفت بـ “الروايات الفكرية” تمامًا مثلما هي الحال بالنسبة لروايات توماس مان، وهرمان بروخ، وروبرت موزيل. ويقول الكاتب الأميركي ربشارد باور إنه بعد أن قرأ “كتاب الضحك والنسيان”، و”كائن لا تحتمل خفته”، اتخذت الرواية لديه “وجهًا جديدًا ومنعرجًا غير مسبوق”. ويعود ذلك بحسب رأيه إلى أن كونديرا يحرص في كل أعماله على أن تكون القصص التي يرويها مرفوقة بتأملات فكرية وفلسفية عميقة. وأما الكاتب جوليان ريوس فيرى أن كونديرا يتحاور من خلال رواياته ودراساته النقدية مع سابقيه من الكلاسيكيين والمحدثين على حد السواء. وهو يخرجهم من أماكنهم المعتادة، ومن مخابئهم الأكاديمية لتحديد رؤيتنا للرواية الغربية. لذلك كان كونديرا على حق في استعمال عبارة “الرواية التي تفكر”…
ومُلخصًا رؤيته للرواية، كتب كونديرا يقول: “أنا أحْذر من كلمات مثل تشاؤم وتفاؤل. الرواية لا تؤكد على أيّ شيء. هي تبحث وتطرح أسئلة. وأنا لا أعرف إن كانت بلادي ستنقرض أم لا. ولا أعرف أيضًا أي شخصية من الشخصيات التي ابتكرتها هي على صواب. أنا أبتكر حكايات وأجعلها في مواجهة بعضها البعض. تلك هي طريقتي في طرح الأسئلة. إن حماقة الناس هي أنهم يعتقدون أن لهم أجوبة على كل الأسئلة”.
ويضيف كونديرا قائلًا: “إن حكمة الرواية هي أن تكون سؤالًا. وعندما خرج دون كيخوتي ليواجه العالم، بدا له هذا العالم غريبًا ومثيرًا للحيرة والسؤال. ذاك هو الدرس الذي تعلمناه من أول رواية أوروبية. الروائي يعلّمُ القارئ بأن العالم سؤال. هناك حكمة وتسامح في هذا الموقف. في عالم مبنيّ على اليقينيّات والمسلمات ّالمقدسة، تموت الرواية. العالم الشمولي سواء كان دينيًا أم أيديولوجيًا، أم غير ذلك، هو عالم الأجوبة الخالي من الأسئلة. في عالم كهذا لا مكان للرواية ولا وجود لها. وعلى أية حال، يبدو لي أن الناس يخيّرون في عالم اليوم أن يحكموا عوض أن يفهموا، وأن يجيبوا عوض أن يسألوا. لذلك فإن صوت الرواية يجد صعوبة ومشقة في اختراق الضجيج الأحمق لليقينيات والمسلمات الإنسانية”.
ضفة ثالثة




