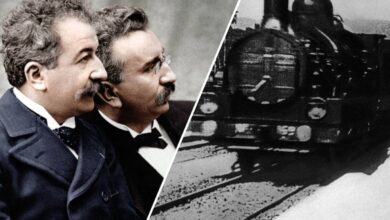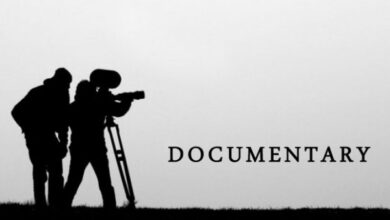“الفتاة ذات الإبرة”.. مأساة امرأة وحيدة في عالم ما بعد الحرب/ أحمد الخطيب

تحديث 24 شباط 2025
لا تمنحنا الأفلام التاريخية النوعيّة تلك الدقة والانضباط المرتبطَين بالوقائع، بقدر ما يبذل صناعها مجهودا هائلا لخلق دراما حقيقية فيما وراء الحوادث التاريخية، لا سيما عندما تحاول القصة التحرك من حدث أساسي أو شخصية تاريخية.
وبدون ذلك التتبع، تصبح مرجعية القصة أكثر عمومية، تعتمد على السياق التاريخي، لكنها تتأرجح بين ما هو متخيل وما هو حقيقي، فيتيح ذلك مجالا أوسع لتشريح الحقبة التاريخية ذاتها، على مستويات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويمنح صناع الأفلام فرصة حقيقية، لتصعيد الأحداث بالطريقة المناسبة للحكي، من دون تقيد بالشخصية التاريخية أو الحوادث المؤرخة.
فخلق خطوط موازية تتحرك نحو الحدث أو الشخصية التاريخية، يرفع قيمة الحكي على المستوى الدرامي، ويؤدي إلى تعرية ما وراء التوثيق؛ فهو يبني وجهة نظر مدعومة بدوافع اجتماعية واقتصادية، يمكن أن تبرز منظورا مختلفا تماما عن المروية المؤرخة.
لا يعد فيلم “الفتاة ذات الإبرة” (The Girl with the Needle) مجرد دراما تاريخية نمطية، بل يختار مخرجه “ماغنوس فون هورن” أن يقدم ما هو درامي على ما هو تاريخي، فلا ينطلق من المثبت تاريخيا، بل يتلاعب بالأحداث لكي يخلق نسقا خاصا في السرد.
“كارولين”.. فرس السرد الذي يراهن عليه المخرج
يختار المخرج شخصية “كارولين” (الممثلة فيك كارمن سوني) المتخيّلة، لتصبح بطلة الفيلم بدلا من شخصية “داغمار أوفربي” (الممثلة ترين ديرهولم) المختارة تاريخيا.
وهنا يمكننا أن نرصد لعبة الاختيارات الفنية، التي يحدد بها المخرج طريقة سرد حكايته. فلو فضل تتبع شخصية “داغمار” من البداية لأصبح الفيلم شيئا آخر تماما، وتغير إلى فيلم قاتلة متسلسلة، يميل أكثر إلى سمة الرعب والإثارة.
ولكنه اختار المخيال فوق التوثيق، ليتقصى حكاية بطلته المهمشة، التي يشرح من خلالها الواقع الاجتماعي لطبقة اجتماعية كاملة عقب الحرب العالمية.
قصة من أيام الحرب العالمية تشبه عالمنا
يرصد “ماغنوس” عالما لا يختلف كثيرا عن عالمنا الحالي، فالإشكاليات التي تواجه البطلة هي نفس إشكاليات مجتمعاتنا الحالية، لذلك فإن الاختيار الإبداعي خلق امتدادات للقصة، كان ممكنا اختزالها بشكل مخل في دوافع القتل لدى “داغمار”.
لكن المعاناة التي لم نعرض لها بشكل ميلودرامي مبتذل، أضافت “سمات” و”دوافع”، ووسعت المنظور خارج نطاق الشخصية التاريخية، فأصبحت “كارولين” في نقطة ما داخل الفيلم مجرد إنسان، يمكن أن نتوحد مع تجربته، ونشاركه الهموم الاجتماعية وضنك العيش.
يدور الفيلم في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وحول بطلته “كارولين”، وهي عاملة شابة في أحد المصانع، حوّلت نشاطها تحت ضغط الحرب لتخدم في الجيش.
نتتبع نمط حياة “كارولين” القاسي وهي تحاول النجاة اليوميّة، بإيجاد مكان للعيش يُناسب حفنة القروش التي تكسبها مقابل ساعات العمل الشاقة في المصنع، بعد أن طردها مالك العقار القديم، لتخلّفها عن سداد الإيجار عدة أسابيع متتالية.
حياة ثقيلة في ظل الحرب الممتدة سنوات
فضّل المخرج “ماغنوس فون هورن” افتتاح فيلمه بفعل الطّرد أو الإقصاء، واتخذه فعلا تأسيسيا لما سيكون فيما بعد النواة المركزية التي سيتحرك حولها الفيلم.
ففكرة الرفض ذاته تحوم فوق الرؤوس، حتى أصبحت جزءا من تكوين النماذج البشرية في تلك الحقبة، فالبؤس الاقتصادي والانهيار الاجتماعي لا يخلفان إلا الفردانية والانسحاب داخل الذات، لدرجة تجعل الآباء يرفضون أبنائهم، فالظرف الاجتماعي لا يسمح بالخروج عن الذات، ولا إدارة الحياة خارج إطار الفرد الواحد.
هذا ما نلاحظه من اللحظة الأولى، في ظل الحرب الذي هو أبعد من مد البصر، ظل لا يختفي بانتهاء الحرب، بل يغطي الأعين سنوات عدة، تسهم في تشكيل فرد جديد يتسق مع البنية الاجتماعية التي خلفتها الحرب.
لقاء الرجل الثري.. استراحة من الألم في قصة حب
تسعى “كارولين” لإيجاد مكان لنفسها في المجتمع، ليس مكانا مرموقا، بل مجرد الوجود ذاته أصبح مشقة بالغة، فغياب زوجها في الحرب زمنا طويلا بلا مراسلات ولا إشارة لكونه ما زال حيا جعلها تفقد الأمل اتجاهه، وفكك روابط الحب بينهما.
لذا كان عليها أن تواجه العالم وحيدة، حتى وجدت نفسها فجأة مع أحد الأثرياء؛ ألا وهو مالك المصنع الذي تعمل فيه، ويدعى “يورغن” (الممثل يواكيم فيلستروب)، فيبادلها الحب، ثم تتصاعد العلاقة حتى يقرر أن يتزوجها، فهي تحمل بطنا منتفخا الآن، يعيش فيه ابن أحد الأثرياء الأرستقراطيين.
تتعقد الأمور عندما يرجع زوجها “بيتر” (الممثل بشير زكري) من الحرب مسخا مشوها، لم يأخذ من الحرب إلا التشوهات الجسدية وخيبات الأمل، فأصبح إنسانا آخر لا يملك إلا حفنة من المشاعر، ورغبة في الحياة إنسانا لا مسخا.
ترفضه “كارولين” كما رفض المجتمع “كارولين” سابقا، لا سيما وقد أصبح رجلا آخر لا تعرفه، كما أنها الآن في علاقة آمنة، ستجلب لها الأمان المادي والاجتماعي.
كابوسية الحلم الجميل
لا تمنح الحياة “كارولين” في تلك الحقبة الكبيسة سوى خيبات الأمل، فالأم الأرستقراطية ترفض قطعا زواج ابنها من إحدى الرعاع المهمّشين، وفي ذلك الوقت ستشعر أن الطبقة الدُنيا إذا اختلطت مع الطبقة العليا، فستنحدر الأمور إلى الحد الذي لا تملك فيه النساء بطونهن.
ومع انتهاء مشروع الزواج، يصبح الحلم الجميل كابوسا، وتعود “كارولين” لحقيقة أنها نصف إنسان، وحفنة من خيبات الأمل. ولكن هذه المرة لها بطن منتفخ، فتحاول التخلص من الطفل بمساعدة الإبرة التي تعمل بها في المصنع.
ومن تلك النقطة في منتصف الفيلم، تبدأ شخصية “داغمار” تظهر، وتتبدى في هيئة المخلّص الذي ينقذ الطفل من الموت، والأم من المضاعفات الخطيرة التي قد تصل للموت، وتطمئنها بأن لها جمعية سرية تأخذ الأطفال، وتمنحهم لإحدى العائلات التي تكفلهم ليعيشوا حياة لائقة. ثم تلد “كارولين” طفلتها وتسلمها لـ”داغمار”.
“العالم مكان مروع”
قبل أن تدخل “داغمار” في القصة، يرصد المخرج حركة العنف التاريخي المتأصل في هذه البقعة، ليس عنفا لحظيا ولا مؤقتا، بل تسلسل من الأحداث المؤلمة والعنيفة، يؤطرها المخرج في النصف الثاني من الفيلم مع ظهور “داغمار”، المرأة التي نعرف الكثير عن تاريخها في الفيلم.
يمنحنا الحوار واللقطات وعلاقة “داغمار” بابنتها إشارات حول هذه المرأة المريبة، فهي وحيدة لا ترعى علاقتها بالرجال، وما حضورهم في حياتها إلا حضور رمزي مرتبط بالجسد، وهي امرأة تتعامل مع الحياة بمنطق عملي تماما، كوّنته بعد مراكمة خبرة كبيرة على مدار حياتها.
ويمكن اتخاذ جملة من حوارها مع “كارولين” مفتاحا لفهم الشخصية: “العالم مكان مروع، ولكن يتحتم علينا تصديق أنه خلاف ذلك”.
عبارة “العالم مكان مروع” هي الوصف الأدق لعالم وحشي، بيد أن المخرج “فون هورن” لم يعامل الشخصيات من هذا المنطلق، بل وقف عند نقطة الحياد منها.
هذه الطريقة هي منهجية “فون هورن” السينمائية، فهو لا يشيطن الشخصية ولا يحاكمها أخلاقيا، بل يرصد الواقع الاجتماعي كله، ويراه وحدة واحدة، رافضا الميلودراما المبتذلة التي كان يمكن أن تفسد الفيلم، أو تقيده في نوعية فيلمية واحدة.
شر الإنسان العادي ابن بيئته
يتعاطى الفيلم مع الشر بطريقة مجردة، من خلال النمط البصري الذي يُبقي المشاهد على مسافة من الأبطال في أزماتهم وانهيارهم، والأهم أنهم على مسافة من العنف الذي يمارسه المجتمع عموما، وتمارسه “داغمار” خصوصا.
فنحن لا نقترب من قتل الأطفال، بل نتابعه من بعيد، من دون أن نتورط فيه تورطا مباشرا، ولكن هذا لا ينفي وجودنا داخل المشهد نحن المتفرجين.
إلى جانب ذلك، فاشتباك المخرج “فون هورن” مع فكرة الشر ذاتها تأتي بشكل مختلف وذكي، فهو لا يتدخل ليبرز الشرور في أشكال دموية أو شيطانية، ولا يصبو لحكمة نهائية أو رسالة، بل يتبنى أسلوب “تفاهة الشر” للفيلسوفة “حنا آرندت”.
ثم إنه لا يؤطر شخصية “داغمار” على أنها نموذج منحرف أو سادي، أو وحش لا أخلاقي، بل إنسان شديد العادية، ابن بيئته وزمنه، وهذا ينقل مضمون الحكاية إلى مستوى فوق مادي، يجعلنا ننتبه للمحيط أكثر من الشخص.
فالشخصيات إنما هي مُنتج المحيط الذي كونها، والصدمة والرعب لا يكمنان في الفعل ذاته بقدر ما يرتبطان بمنطق عالم غير مبال، يمكنه ببساطة استيعاب ذلك النوع من الشرور.
سردية مقاومة للتطهير والشرور المتجددة
الجدير بالذكر أن سردية “فون هورن” هي سردية مقاومة للتطهير، فالشر يقع في مساحة ملتبسة، وكذلك فعل التطهير ذاته يأخذ أشكالا شتى، يمكن أن يستوعبها مجتمع ما بعد الحرب، لا سيما مع استفحال الفردانية في المجتمع.
فربما رأت “داغمار” أن أفعالها أفعال تطهيرية أو خيّرة في جوهرها، وهذا يمنح الرعب قدرة على الاستمرار والامتداد، لأن الظروف المواتية لاستمراره تتجدد باستمرار سيران ذلك النمط الاجتماعي.
لذلك يرفض الفيلم الحلول السهلة، ولا ينتهي إلى نقطة العدالة الإلهية أو الإنصاف الوجودي، بل ينزع إلى تقديم قصته على أنها مأساة حقيقية، ونتيجة حتمية لواقع يعزز المحو، ويحفز على العنف، ويحث على التخلي، وينبهنا إلى أن المأساة تتكرر في أشكال شتى.
ومع أن الفيلم تاريخي، فإنه لا ينفصل عن النظرة المعاصرة للعالم، فمأساته مكررة في كل حقب التاريخ، وكلها موجودة في منتج إبداعي يتميز بلغته البصرية البديعة، مع قدرة استثنائية على الوقوف على كل مشهد والتأمل.
فقدرة الفيلم على التباطؤ لا تعطل جريان القصة، بل تفيدها على أكثر من مستوى، أهمها تسليط الضوء على المحيط، والإطار الخارجي الذي يحث الأبطال على التصرف بطريقة معينة.
اسم الفيلم بالانجليزية
THE GIRL WITH THE NEEDLE
الجزيرة